عبـــــــدالله خلــــــــيفة's Blog: https://isaalbuflasablog.wordpress.com , page 21
February 20, 2024
الفلسفة الغربية والنهضة العربية : كتب ـ عبدالله خليفة
يختلف زمن التطور الغربي الفلسفي عن التطور الفكري العربي، ليس بسبب اختلاف التشكيلتين، حيث تجاوز الغربيون التشكيلة الإقطاعية واستمر العربُ فيها، بل أيضاً في ضخامة الإنتاج الفلسفي الغربي وشبه انعدامه في فترة النهضة العربية، خاصة في هذا المخاض الغربي الفكري الكبير في القرنين التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين، وهي الفترة التي تصاحب زمن النهضة العربي الأول، حيث غادر الغرب فلسفات وأفكار النهضة، ولكن ليس بشكل كلي مطلق، فمازالت هناك بقاع لاتزال تستعر بصراع النهضة المتجسد في الصراع بين الحداثة والتقليد، بين البرجوازية والإقطاع خاصة في الأقطار الاوروبية الجنوبية والشرقية، لكن قلب أوروبا كان قد انتقل من فلسفات النهضة إلى فكر الحداثة المتصف بغلبة الاتجاهات المادية والمثالية الموضوعية خاصة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، عبر ولادة الهيغلية والماركسية والوضعية والداروينية.
«كانت فلسفات القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين قد دافعت عن تصور «كوني للعالم وكان المذهب الميكانيكي يرى أن آلة العالم قد أرسيت قواعدها مرة وإلى الأبد، وأنها مجموعة هائلة من التروس لا يفقد منها شيء، ولكن لا يخلق فيها شيء أيضاً»، «الفلسفة المعاصرة في أوروبا، إ. م. بوشنسكي، عالم المعرفة، العدد 165، الكويت، 1992».
إن توجه أوروبا الغربية خاصة لفلسفات تتوجه لاستيعاب الحركة الشاملة، تم أولاً بشكل مثالي موضوعي عبر فلسفة هيجل التي اعتبرت الحركة جزءاً من الفكرة المطلقة ذات الحيوية الداخلية القادرة على النمو والتجاوز والنفي، وبهذا فإن المثالية الموضوعية هنا راحت تضم العالم المادي عبر هيمنة الفكرة المطلقة ولكنها تكشف تحولات هذا العالم المادي عبر قوانين الجدل.
وكان الشكل الأول لتخطي الهيغلية المثالية قد تم عبر فلسفات مادية ميكانيكية، ففويرباخ وبوخنر وكارل فوجت «قد نفت مذاهبهم وجود العقل ذاته ودافعت عن الحتمية الشاملة».
لا بد أن نقول إن هذه التطورات الخصبة لنفي الميكانيكية ولتثبيتها في مذاهب جديدة، قد تشكلت على ضوء التحولات الشاملة في الصناعة والعلوم والتغيرات السياسية الديمقراطية في البُنى الاجتماعية؛ حيث أصبح بإمكان العقل البشري الوصول إلى قوانين المادة الداخلية على مستوى العلوم الطبيعية وإلى قوانين التطور التاريخي والاجتماعي والطبيعي.
ولهذا كانت المادية الجدلية نفياً لمثالية الهيغلية ولميكانيكية المادية الآلية. إن ارتباط المادية الجدلية بحركة الطبقة العاملة قد أطلق قدرتها على معرفة العالم والطبيعة بلا أسوار طبقية معينة.
ومن جهة أخرى فإن «الكانتية» والوضعية عموماً ارتبطت بقوى البرجوازية في المناطق الأقل تطوراً من حيث التحولان العلمي والديمقراطي، أي في ألمانيا تحديدا، حيث جرت موضعة العلوم في جوانب حسية جزئية، غير معترفة بالقوانين العامة للأشياء والظاهرات الطبيعية «والاجتماعية خاصة»، وهو جانب علمي مفيد لكنه ضيق الأفق ومحدود المعرفة، وهو من جهة أخرى يعبر عن قطع مسار الطبيعة عن مسار الظاهرات الاجتماعية والفكرية، بحيث ألا تمتد الدراسات العلمية لقوانين الحياة الاجتماعية، وهذا الفصل التقني سيكون مفيداً لهذه الطبقات وهي تشتغل على تطوير قوى الإنتاج أساساً.
هذا ما يعتبره جورج لوكاش بسبب «أن المصير المأساوي للشعب الألماني يقوم في كونه دخل متأخراً في التطور البرجوازي الحديث»، «راجع تحليته الموسع والغني في كتاب تحطيم العقل، الجزء الأول ص 33، دار الحقيقة، ط2 ».
أما المادية الميكانيكية فإنها استمرت عبر ظاهرات متعددة أهمها الداروينية التي كشفت قوانين تطور المادة الحية، والتي ستتمازج والوضعية عبر أوجست كونت والداروينية الاجتماعية عامة. وعبر نقلها قوانين البيولوجيا إلى العلوم الاجتماعية واصلتْ نقلَ قوانينَ الميكانيكا إلى المستويات الأعقد من الظاهرات الاجتماعية، رافضة قوانين المادية الجدلية، وبهذا فإنها كانت أمام طريق مسدود في هذا الجانب.
وقد واجهت الفلسفات المادية أزمة تطور في نهاية القرن التاسع عشر، بسبب أزمة العلوم الطبيعية وعدم قراءتها الجدلية للمادة، وكانت الفلسفة المادية الميكانيكية هي الانعكاس المباشر لمستوى العلوم السابقة، وهذه المادية الميكانيكية هي التي أخذ بها نهضويو العرب في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، كشبلي شميل وسلامة موسى.
إن هذه الأزمة الغربية الفلسفية لم تكن لأسباب فكرية فقط، بل لتحولات علمية ولأسباب اجتماعية غربية ~ كونية، فقد تراكمت في القرن التاسع عشر ثروة معرفية هائلة وظهرت اكتشافات كبرى، فقد عاشت الفيزياء التى صاغها نيوتن في أزمة بعد عدة قرون من هيمنة مفاهيمها الميكانيكية وظهرت فيزياء جديدة لم تعمم فلسفياً بشكل علمي، وأيضاً كيمياء مختلفة، كذلك بدأ تجاوز الرياضيات التقليدية، وهذا كله أحدث تشككاً كبيراً في مسألة المادة، ومن الناحية الاجتماعية والسياسية فقد انتقلت البرجوازيات الغربية للسيطرة الكلية على العالم، ولم تعد الفلسفات المادية والجدلية مناسبة لهذا التطور بسبب تركيزها على تحليل المادة والحياة الاجتماعية، ويقود الغزو الغربي للعالم والصراع على خيرات العالم الفقير إلى صراعات ضارية وهو الأمر الذي سيفجر الحروب العالمية وخاصة، التي ازدادت في أعقابها عمليات «انهيار العقل البرجوازي في تلك العقود».
فإضافة إلى استمرار المثالية فقد ظهر الاتجاه اللاعقلى، «وهو الناتج عن الحركة الرومانتيكية وخَلَفُها، ليعارض المذهب العقلي الهيجلي. وممثل هذا الموقف شوبنهور الفيلسوف الألماني «1788~ 1860»، الذي يرى أن المطلق ليس العقل، بل إرادة عمياء ولا عقلية. وإلى جانب شوبنهور ظهر المفكر الدنماركي كيركجارد «1813 ~ 1855» ليدفع إلى مدى أبعد الهجوم على المذهب العقلي»، «عن الفلسفة المعاصرة في أوربا».
ولهذه الظواهر أسبابٌ متعددة كبروز احتجاجات الفئات الوسطى والصغيرة ضد الأنظمة وهذه الاحتجاجات تتشكل بصورة فردية متضخمة حيناً وبصورة عدمية حيناً أخر، وأحياناً كعودة لفكر الأرستقراطية الكارهة للديمقراطية والأنسنة، خاصة في البلدان المتطورة رأسمالياً ولكن المتشكلة بإرادات عسكرية وسياسية متسلطة كألمانيا وإيطاليا، واللتين سترفدان الوعى العربى بالنمط الحيوي واللاعقلى وسيتمظهر ذلك في ولادة الأحزاب القومية العربية المشرقية خاصة.
وفي مرحلة تالية، وبعد الهجوم على المذهب العقلي الهيجلي، هاجم الاتجاه اللاعقلي المذهب العقلي العلمي، وهو هنا سوف يعتمد في هجومه على نظرية التطور عند دارون. وكان المعبر عن هذا الموقف نيتشه «1844 ~ 1900» الذي يعلن أولوية الاندفاع الحيوي على العقل، ويطالب بمراجعة كل القيم، وينادي بعبادة الرجل العظيم»، «المصدرالسابق».
علينا أن نقول هنا بأن الوعي العربي الطالع من القرون الوسطى المتدهورة، لم يكن بإمكانه نقل هذه التحولات الفلسفية الكبرى ولا حتى معرفتها بشكل واسع وقتذاك، وسيعتمد على نقل جزئي محدود لبعض الاتجاهات القريبة من مستوى معرفته ومن اتجاهاته المعارضة الغائرة، كالاتجاهات المادية الميكانيكية والوضعية، كما نقل طه حسين وإسماعيل مظهر بعض جوانب المادية الميكانيكية ممثلة في المدرسة التطورية الاجتماعية.
إن الاتجاهات المادية والتطورية الاجتماعية الميكانيكية كانت أقرب إلى مستوى الوعي العربي، كما أنها تقدم مادةٍ شبه موضوعية لمعرفة الواقع العربي ونقده، بدلاً من الاتجاهات اللغوية الشكلية والنصوصية التقليدية التي لم تكن تجعل الواقع كبؤرة لنقدها وتحليلها، مثلها مثل الفلسفات العربية الإسلامية السابقة المبهمة وغير المفهومة في هذا الزمن بشكل عام.
إن الوعي العربي النهضوي في مرحلته النضالية بين القرنين التاسع عشر والعشرين لن يلتفت إلى المدارس اللاعقلية والصوفية بشكل واسع، سوى في الاتجاه القومي الانبعاثي في بلاد الشام «زكي الأرسوزي خاصة»، ومن هنا فإن العلاقة واضحة بين اتجاهان شبلى شميل وطه حسين وسلامة موسى والعقاد وفرح أنطون وغيرهم في التركيز على الواقع بمختلف الرؤى، أي وضع الواقع كمادةٍ رئيسية أمام الوعى المدعو للحفر فيها وكشف سببياتها وتحولاتها، سواء عبر ذهاب طه حسين الى تعرية البنية الثقافية العربية التقليدية، وكذلك في نقل سلامة موسى ثمار المعرفة الغربية إلى واقع متخلف ديني هو غير معني بتحليله لأن لديه وصفة جاهزة هي التطورية الداروينية الميكانيكية، وكذلك فعل العقاد في نقد التخلف الإبداعي وطرح نموذج الأبطال الخ..
إن ذلك يبدو أيضاً في الصوفيين الجديد واللاعقليين كجبران خليل جبران وزكي الأرسوزي وغيرهما من الذين استخدموا أدوات دينية صوفية وكانوا أقرب للاتجاه الحيوي عند برغسون والمدرسة الحيوية عموماً، ولكن هاجس نقد الواقع هو المسيطر عليهم بقوة.
وهكذا ففي الوقت الذي كانت فيه الأجنحة اليمينية من الفكر الأوروبي في ذلك الزمن تقوم بالهجوم على ثقافة الطبقات الشعبية المادية والتطورية والعقل بوصفه أداة للكشف، كان المنورون العرب يبحثون عبر كل فكر تحديثي يعبر عن نقد للواقع وعن الرغبة في تغييره وعن إعلاء العقل. ولنتذكر هنا جمال الدين الأفغاني الذي بدأ حياته مهاجماً الفلسفة المادية «الملحدة» في كتابه عن الدهرية ثم تحول إلى تأييد الداروينية والتطورية الاجتماعية!
إن حصول المدارس الفلسفية المادية والتطورية على أغلبية المنورين العرب وتوجه القليل النادر للفلسفة الحيوية والرومانتيكية، يعبر من جهة أخرى عن ضعف الأساس الثقافي العلمي لدى النهضويين العرب، فالمدارس الداروينية والتطورية الاجتماعية المعتمدة على المناهج الميكانيكية كانت تنهار في القارة الأوروبية في الوقت الذي يقوم فيه بعض المنورين بالترويج لها، وبأشكال فجة أحياناً أو صادمة، وهي مناهج وفلسفات كانت غير قادرة على تحليل الظاهرات المركبة كالتاريخ والمجتمع والثقافة، وهذا مما جعل بعضهم يعادون الثقافة العربية الإسلامية بشكل ميكانيكي، دون أن يقرأوا الجدلية الداخلية المركبة لها.
وهكذا كان بعض المنورين العرب يأخذ نتائج ثقافة لفلسفات في طور الاحتضار، وهو غير قادر في الوقت ذاته على الانتقال إلى ثقافة أكثر تركيباً، كما هي حالة شبلي شميل.
لقد كانت الفئات الوسطى العربية المثقفة تستلهم مصادر غربية فكرية نقدية شتى، لكنها تلتقط الأفكار الأقرب إلى مستواها المعرفي، وأغلبها يقع في دائرة الأدب والفن والتاريخ، لتوظيفها في زحزحة السائد الثقافي المتخلف.
إن عدم قدرتها للتوجه إلى الميادين الأعمق كالفلسفة الهيجلية والمادية الجدلية بل وحتى الوضعية، كان يشير إلى هيمنة الطابع الأدبي عليها، وهو أمر سوف يتم تجاوزه في مفكرين قادمين، أخذت فيه المادة المعرضة تتسع وتتعمق عندهم، ويتم فيه جلب مدارس مادية أكثر تطوراً كما أن حضور المدارس التجريبية والوضعية والمثالية الموضوعية سيغدو هو المسيطر على المشهد الفلسفي. لقد انقلب المشهد الفلسفي الأوروبي في النصف الأول من القرن العشرين عن القرن التاسع عشر، قرن الفلسفات التطورية والكفاحية عموماً، إلى مدارس فلسفية لاعقلانية وحيوية صوفية وبرجماتية عملية مع هوامش للفلسفات الوضعية والتجريبية وهي التي كانت تضخها الجامعات الغربية، وهي كلها ترفض كشف القوانين الموضوعية للبُنى الاجتماعية، مما جعل الجيل التالي من المفكرين العرب يبتعد عن الفلسفات المادية متوجهاً للحل الوسط بين اليسار واليمين الفلسفيين، أي إلى الوضعية والتجريبية والمثالية الموضوعية كما سيظهر ذلك في أبرز الأسماء كزكي نجيب محمود ويوسف كرم وناصيف نصار وغيرهم.
لكن الفلسفات المادية ستتركز الآن في «المادية الجدلية» التي غدت هي وريثة الفلسفات المادية الميكانيكية عبر الضخ السوفيتي الشعبوي، وعبر انهيار الداروينية التي لم تعمر طويلا، كما ستتحول عربياً إلى تشويه للمادية الجدلية الحقيقية، وهو مسار سيظل مواجهاً للوضعية وغيرها.
وكما كان قانون البُتى الاجتماعية المسيطرة على المادة الفكرية المجلوبة من الخارج مهيمناً على العصر العباسي، فإن لهذا القانون نفسه سوف يتحكم في المادة المجلوبة من الغرب، هذه المرة وليس من عند الإغريق، فالبناء الاقطاعي – المذهبي سوف يتحكم في المواد الفكرية المجلوبة عبر الحدود، وسيخضعها لقوانينه الداخلية.
فتكون هذه المواد المستوردة في فاعلية الفئات الوسطى، تابعة لمدى استقلاليتها عن الاقطاع الحاكم، وهى أمور تعيودُ للتراكم المادي واتجاهه، ولطبيعةِ الصراعات الاجتماعية ومساراتها، ودور الأفكار في التوجه إلى بؤر تتطور الخ.. فنجد كيف أن المنحيين التطوري الاجتماعي والمادي يخليان السبيل للوضعية – التجريبية وللمثالية الموضوعية والذاتية والأفكار القومية ذات النزعة الحيوية والرومانتيكية، وللمادية الميكانيكية، ثم لاتجاهات بعث الإسلام كنظام إقطاعي مذهبي أي الاعتماد على النصوصية ورفض اتجاهات التأويل العقلانية، أي العودة لمرحلة ما قبل الفلسفة الإسلامية في العصر الوسيط، وهو ما يعبر عن انبعاث النظام الاقطاعي ~ المذهبي، رغم التطورات الراسمالية الجزئية. أي أن اتجاهات الفئات الوسطى وممثليها الثقافيين ستنحو نحو التراجع عن التحديث الأوروبي، والعودة للهياكل الإقطاعية، وستتعزز هذه الاتجاهاتُ عبر ابتعاد العالم العربي الإسلامي عن مراكز النهضة في مصر ~ لبنان إلى الجزيرة العربية – إيران، بل إن هذه المراكز نفسها ستواجه موجات التخلف والتفكيك الطائفيين، مما يجعل المناطق البدوية والفلاحية المهيمن عليها من قبل الإقطاع المذهبي المتخلف، تتحكم في إنتاج الوعي عامة، وهذا سيؤدي إلى تراجع حتى على مستوى الفلسفات الوضعية والتجريبية والمثالية.
February 19, 2024
وحدة فكر النهضة : كتب ـ عبدالله خليفة
طرح مشروع التغيير في العراق مسألة أي فكر يهيمن على البلاد ويقودها في مشروعه السياسي .
وقد رأينا نماذج من التناقض الحاد بين التطرف العلماني والتطرف الديني وكل منهما يسعى للتحكم المطلق في الخريطة السياسية والدينية المنوعة .
بدأت القصة حين اندفعت الجماعات الدينية المتطرفة في منع الخمور والهجوم على محلات بيعها وحرق هذه المحلات، وما تسبب ذلك من إزهاق أرواح واعتقال هؤلاء الحارقين، وثمة أناس يعتبرونهم أبطالاً وثمة أناس يعتبرونهم مجرمين، لكن القانون ياخذ مجراه ويعتقل هؤلاء وتنطلق القضية بغض النظر عن الحيثيات الدينية!
وهنا يعمل الفقه المحافظ المنتج في قرون سيطرة الإقطاع الديني على تحويل أية قضية شرعية إلى رافعة ضد التطور والحداثة، سواء كانت قضية خمور أو قضية تحرر نساء أو قضايا حقوق شخصية وممارسات جنسية حرة أو قضية فقراء، مستهدفاً في ذلك الوصول إلى السلطة السياسية المطلقة، إذا وجد إليها سبيلاً، وإذا لم يجد اكتفى بحضوره الكبير فى السلطة الاجتماعية، أي الهيمنة على الحياة اليومية للمؤمنين به. أو أنه يعمل بكافة السبل العسكرية أو السياسية الانتخابية المجيشة بهدير ديني تحريضي طائفي، للوصول إلى السلطة، وتحقيق برنامجه السياسي في هيمنة الملالي المنتمين لمذهبه على الحكم.
ومن الجهة المعاكسة يسعى بعض الفكر العلماني المتطرف إلى تبرير أي جانب من الحقوق الشخصية والحريات، واعتبار الإسلام هو العائق الأكبر أمام تطور وحرية المنطقة!
تقوم الديمقراطية العربية الراهنة المزعومة على استمرار النظام الطائفي الإقطاعي العربي القديم، بدون المناقشة في أن هذا النظام لا يمكن أن ينتج ديمقراطية حقيقية، تعتبر الانعطافة الديمقراطية المنشودة!
أي أن وجود دولة طائفية تهمين على الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية لا يمكن إلا أن يشكل معارضة طائفية مضادة، ولا سبيل لخلق ديمقراطية سوى بتجاوز الكتلتين : كتلة الدولة الطائفية، وكتلة المعارضة الطائفية!
ومن خلال الكتلتين تتشكل فسيفساء سياسية كاذبة في أغلب تلاوينها، فالقوى السياسية المقتربة من الدولة الطائفية تشكل معارضة ديمقراطية ترفض طائفية الدولة واحتكارها للسلطات، وهنا تتنطع هذه القوى في عرض ليبرالية مجردة كاذبة، أي أنها تركز في خطابها على مهاجمة طائفيي المعارضة، لا طائفية الدولة، أي لا تقوم بتحليل موضوعي ينقد كافة الطائفيين سواء الحكوميين والموالين للحكومة أو المعارضين، بل هي تقوم بعملية انتقاء انتهازية، وذلك بأن تعرض خطابات مجردة أو مقطوعة السياق وغير شاملة ودقيقة، وذلك بفرض إشاعة وعي تابع للسلطة الطائفية، التي تقوم بعرض جوانب ليبرالية جزئية من عملها ونشاطها، متغاضية عن الجوانب السيئة، بغرض تبييض صفحتها والدعاية لنهجها السياسي، أو على الأقل إبعاد موظفين وشرائح معينة من سيطرة خطاب المعارضة الطائفي المناوئ.
هذه لقطة صغيرة من الديمقراطية العربية الراهنة!
وفي الجهة المقابلة تركز المعارضة الطائفية على إخفاء طابع معارضتها الطائفي، أي إخفاء هويتها السياسية التي تعني وصولها إلى الحكم، وقلع حكم الطائفة الأخرى، كما يصور لها وعيها السياسي الطائفي.
فهي لا ترى قسمات اجتماعية أو وجود صراع اجتماعي بين الكتلة الساحقة من المواطنين المنتمين لهذا القطر العربي أو ذاك، وبين الكتلة الصغيرة من كبار الملاك وأصحاب الأموال والشركات المهيمنة على جهاز الدولة، وعبره شكلت ثرواتها.
إن الوعي الطائفي المعارض عادة يقوم بتمويه طابع المعركة الاجتماعي، وإخفاء دلالاتها الطبقية، وانعكاساتها السياسية، فيظهر معارضته كما لو كانت هي دفاع عن كل المواطنين، وكما لو كانت هذه المعارضة ستشكل سلطة أخرى غير طائفية، في حين إن المضمون الداخلي الغائر والظاهر يوضح انها جماعة طائفية أخرى، لا تختلف عن طابع السلطة الطائفي!
إذن فلو استمرت هذه العملية وجاءت الطائفة المعارضة للحكم، فإن التغيير سوف يجري في الشكل، أي أن كبار المهيمنون على الطائفة الأخرى هم الذين سيصلون إلى الحكم وبالتالي فإنهم سيمتلكون الشركات والمال العام، وفي حالة كونهم رجال دين فإنهم سوف يمتلكون ثروة البلاد وثروة السماء معاً!
ومن المؤكد إن الليبراليين التابعين للدولة، أي للطائفية الرسمية المسيطرة، أي لوجه الحكم الإقطاعي بوجهه السياسي، لديهم حق في نقد خطاب رجال الدين الشمولي، ولكن هذا الخطاب الديني الشمولي ليس حكراً على رجال الدين الطائفيين المعارضين أو الموالين، بل هو جزءٌ أساسي من خطاب الدولة الطائفية!
فالدولة العربية وغير العربية الدينية تقوم على أساس طائفي، وسواء كانت سنية أم شيعية أم مسيحية، أم شافعية، أم زيدية، أم مالكية الخ.. فإنها تقيم سيطرة المذهب، الذي هو تعبير أيديولوجي عن سيطرة الإقطاع السياسي/ الديني .
أي أن المذهب الإسلامي المعني، لا يمثل حقيقةً كل الطائفة الإسلامية، المفترض أنها هي التي في السلطة بحكم أن المذهب الرسمي للدولة يمثلها، لأن المذهب الرسمي هنا مجرد شكل، خالٍ من التمثيل السياسي للطائفة المعنية التي يقال بأنها هي التي تحكم!
فلو افترضنا جدلاً بأن الطائفة السنية هي التي تحكم في العراق يحكم أن المذهب الرسمي المعتمد في كل الدولة العراقية يقوم على المذهب السني. ولكن أي تحليل بسيط يبين خرافة هذا الوهم الإيديولوجي، في الطائفة السنية لا تحكم العراق، لا من الناحية المذهبية ولا من الناحية السياسية!
فالأحكام الشرعية المتعددة بين المذاهب ليس بينها أي فوارق فكرية أو سياسية جوهرية تقلب كيان المجتمع قلباً اجتماعياً جوهرياً شاملاً، بل هي اختلافات بسيطة حول الوضوء والإرث والصلاة الخ.. أي أن تكريس الدولة العراقية للمذهب السني في المحاكم والحياة العامة، مجرد تكريس لبعض جوانب عبادية شكلية لا تختلف نوعياً عن الممارسات الشيعية والإسماعيلية والزيدية الخ..
أي أن الفروق بين المذاهب الإسلامية مجرد فوارق شكلية، ليس فيها مثلاً اشتراط أن يكون الحاكم منتخباً بالاقتراع السري! أو من بينها مثلاً أن يكون الحاكم من الكادحين أو من طبقة الصناعيين أو أن تقطع يد الحاكم في حالة السرقة!
وبهذا فإن الحكومات المذهبية المتعاقبة في العالم الإسلامي، لم تكن تجري تغيرات جوهرية ونوعية في حكمها ساعة تبدلاتها الكثيرة والدموية في أكثر الأحيان!
فنحن لا نلحظ تغييراً حين أعقب العباسيون الإماميون الأمويين الانتهازيين الدينيين، أو حين جاء الإسماعيليون لحكم مصر وأطاحوا بالخلافة العباسية، أو حين أطاح صلاح الدين بهم وأقام الدولة على المذاهب السنية، أو حين أطاح الإثنا عشرية بالحكم المغولي أو التركي السني ! أو حين صار أهل شمال افريقيا مالكية بعد أن كانوا من الخوارج، وربما كان هذا يعبر عن خضوعهم للسلطة القاسية أكثر من اقتناعهم بالمالكية!
لم يشهد العالم الإسلامي في تحولات الحكومات المذهبية أي تغيير، فأختكِ مثلكِ، لأن الملاك الكبار، الحائزين على الثروات، هم الذين يستبدلون الكراسي، وهم الذين ينعمون بالامتيازات، ولم نجد حين استولى صلاح الدين وأطاح بالإسماعيلية بأن كادحاً مصرياً سنياً حصل على أرض، أو أن الفاتح الكبير والمحرر الكبير قد غير من طبيعة استغلال الفلاحين السنة أو المسيحيين، الذين لم تتغير عليهم كميات الخراج ولا سياط الملتزمين!
ولم نر ان الإثناعشرية حين حُكم باسمها في إيران أيام الدولة الصفوية أو أيام الجمهورية الإسلامية الحالية قد غيرت من وضع الفقراء والفلاحين ولا يزال هؤلاء مستغلين منهوبين للدولة والاقطاع الدنيوي والديني ممنوعين من الإصلاح الزراعي الذي حتى الشاه الراحل قام بتطبيق جزء منه!
فلم يستطع الفرد الشيعي سواء كان في الحكم الطائفي أو المعارضه الطائفية أن يحكم، أو حتى يقترب من السلطة، التي ظلت لأصحاب الملايين والمليارات حالياً!
إذن فإن الحكومات العربية وغير العربية الدينية التي تحكم باسم المذاهب والطوائف لا تمثل حتى الطوائف التي تزعم تمثيلها، وكذلك فإن المعارضات الطائفية التي تزعم تمثيل الطوائف هي لا تمثل الطوائف!
والأمر بسيط لأن الطائفية دكتاتورية!
والأمر يعود أيضاً لهذه الأدلجة التي تمت للمذاهب، ولعمليات تسييسها ولاخفاء مضامينها، عبر السيطرة المستمرة لكبار المتنفذين والأغنياء والمتسلطين عليها، والذين قاموا بشكلنتها، أي بجعلها شكليةً، متمحورة في الأشكال العبادية التي عملوا على تركيز الاختلاف فيها، والمحافظة على هذه الاختلافات بغرض إبقاء سيطرتهم السياسية والاقتصادية على جماهير المسلمين العاملة، واستمرار استغلالهم لها، وإبقائها في ظروف الفقر والعوز والتخلف والفرقة والعداء!
إذن أمام قوى المسلمين المختلفين المنهوبين المستغلين المبعدين دائماً عن الحكم الحقيقي، أن ينسحبوا من عباءات التسييس المذهبي ويتوحدوا!
إن التسييس المذهبى هو دكتاتورية، لأنه رفض لوجود الفقراء والمستغلين، لأنه رفض لكيانهم الاجتماعي المستقل، رفض لوجودهم كقوى اجتماعية مختلفة عن الأغنياء المتحكمين في الطوائف كلها!
فلماذا يخافون أن يتوحد الفقراء سنةً وشيعة ومعتزلة وزيوداً ودروزاً ومسيحيين وعلمانيين وليبراليين وماركسيين؟
لماذا يشكلنون المذاهب ويجعلونها أشكالاً تخفي سيطرتهم المالية على الأراضي والبنوك والمال العام، ولا يريدون لفقراء المسلمين وعامليهم وفئاتهم التجارية البسيطة أن تتوحد وتدافع عن حقوقها وعن أوضاعها السيئة في الأجور والسكن والصحة والتعليم؟
إن هذا بسبب أن الكثير من المثقفين المسيسين تابعين لمثل هذا الوعي الطائفي الطبقي التابع للكبار .
لماذا جعلوا أقوال الأئمة شكلانية ووسائل بهدف سيطرتهم على البساتين والأسهم والعقارات؟
لماذا لا يحررون الأئمة من هذه السيطرة ويطرحون برامجهم السياسية والاقتصادية بشكل مكشوف ودون تستر بالمقدس؟
لماذا لا يجتمعون في طبقة مالكة من شتى المذاهب تطرح برنامجها الاقتصادي والاجتماعي الذي يحفظ ويوضح مصالحها وحتى أن تجذب الناس المختلفين اجتماعياً من خلاله؟!
لماذا يزعمون أنهم يتعاركون على الدين والمذاهب وهم يتعاركون على المصالح والكراسي؟!
هذا يتطلب نهضويين وديمقراطيين ينبثقون من شتى المذاهب ويؤسسون حركات ديمقراطية عميقة تقوم على هذه الأسس الفكرية!
حركات تقوم بإبعاد المذاهب عن هذا الاستخدام السيئ للمذاهب وتجمع الفرقاء الاجتماعيين كلٌ وأهدافه دون تستر براية مذهبية أو بسلطة طائفية!
قضايا حقبتنا : كتب ـ عبدالله خليفة
اعتمد الفكر الغربي المركزي على تصدير خطوطه الفكرية إلى العالم، من دون أن يجعل الأمم غير الغربية تنتج أفكارها من تطورها الخاص، سواء أكان ذلك في تصدير المنهجيات الحديثة بشتى طرائق بحثها، أم بتصدير الأفكار الخرافية والدينية والأسطورية والفاشية الخ..
وحتى اليسار المناضل في الغرب صدّر مثل هذه الأفكار سواء في الفكر الاشتراكي الديمقراطي أم الشيوعي، وأحياناً يقوم أبناء الشرق أنفسهم باستعادة وترجمة واستيراد مثل هذه الأفكار، وهو أمر مفيد ولكن الأمر لا يغدو تأصيلاً وحفراً داخل طرائق تطور هذه الأمم.
إن المنهجية الموضوعية مهمة وهي نتاج يعلو على ظروف الأمم الخاصة ومصالح طبقاتها المسيطرة، ولكنها تحتاج إلى علماء، أي إلى متخصصين يغرسونها داخل ظروف مجتمعاتهم ومن أجل مصالح أممهم.
فقد تورطت بعض فصائل التقدميين العرب باستيراد الموديل (الشيوعي) على سبيل المثال، أي استيراد لافتة حزبية أكبر من حيز مجتمعاتها، وتعبر عن السياسة الروسية في زمن سابق، وبالتالي تطرح قضايا ومهمات غير ممكنة، ليست فقط غير ممكنة على مستوى العالم العربي الإسلامي الإقطاعي الذي يواجه إزاحة الحياة التقليدية المتخلفة، بل أيضاً على مستوى حياة روسيا والصين وشعوب الشرق عامةٍ.
ليست لأن الاشتراكية والشيوعية مستحيلة على صعيد تطور الإنسان القادم، بل لأن هذه قضايا فوق مستوى مثل هذه الشعوب، التى تواجه قضايا أقل من هذه القضايا المركبة المستقبلية، وتلك القضايا من الممكن أن تطرح على مستوى الأمم الغربية التي اجتازت مراحل كبيرة من التطورين الصناعي والعلمي.
وقد حاولت فصائل عربية عديدة توريط التقدميين البحرينيين في مثل تلك التسميات من دون أن ينجحوا في إلباسهم إياها.
فاكتفى التقدميون البحرينيون بمهمات (التحرر الوطني والتقدم) معتمدين على حس واقعي وعلى رفض أساليب المغامرة في العمل السياسي.
لكن الآن وبعد تجارب كبيرة شهدها العالم أصبح تجذير هذا الوعي يتطلب علوماً ولم يعد الحس كافياً.
إن التقدميين الذين يقفزون على حقبتهم، وجدناهم في العديد من الدول العربية يواجهون جدرانا صماء، فبلدان لا تزال تناضل من أجل فقط إخراج النساء من ظلمات البيوت ومن عوالم الجهل والسمنة المرضية، وينغرس فلاحوها في الطين ويعيشون بين البقر، وتحتاج هذه البلدان إلى توحيد البدو بأهل المدن وإلى ثورة معرفية وغيرها من المهمات، مثل هذه البلدان ظهر بينها الاتحاد الاشتراكى وحزب البعث الاشتراكي والعديد من الأحزاب الشيوعية، طارحةٍ أسماء تعود إلى حقبة أخرى تالية، لأناس سوف يظهرون لاحقاً، ولا ندري متى؟
والغلط ليس في الأسماء، بل في هذه العقلية التي تفترض مهمات كبرى لمجتمع لا يحتمل مثلها، كأنها تعد طفلاً لسباق الحواجز، وهو أمر يجعل بين الأهالى وبين هذه الأحزاب هوهٍ كبيرة، ليست معرفية فقط بل سياسية أيضاً، وهكذا وجدت هذه الأحزاب نفسها تنفصل عن الموروث، حيث تدعوها العقلية الغربية ذات المهمات المغايرة، إلى الانفصال عن هذا الموروث (المتخلف).
وحتى في هذه السنوات التي تشكو المجتمعات العربية من الظمأ إلى الشركات والمصانع ومن قلة انتشار محلات الانترنت، لا يزال بعض (الاشتراكيين) يرفض الرأسمالية (المتوحشة). في الوقت الذي يحتاج فقط الريف العراقي الى السلام والعمل، وتنضب دكاكين فلسطين من السلع ومن الأعمال، وينضب الريف العربي من الجرارات الزراعية!
لقد سجلت المجتمعات العربية أدنى درجات التحديث عالمياً، أرقاما هائلة في البطالة وفي الأمية وتخلف النساء، الأمر الذي يتطلب واقعية في النظر السياسي لدى طليعي المقاهي.
هذا لا يعني ألا يناضل الديمقراطيون والليبراليون والدينيون من أجل الفقراء وحقوق العمال والنساء والحرفيين، فهذه قضية مختلفة، لكنها تُؤخذ في إطار العمل الواسع من أجل التنمية والتحديث والرأسمالية كذلك!
February 18, 2024
(الطفولية) والنضال المعاصر : كتب ـ عبـــــــدالله خلـــــــيفة
يعبر (الطفوليون) السياسيون عن فقدان البصيرة الموضوعية، وتحكم مشاعرهم الحادة في سلوكهم، ويمثلون فرصة للاتجاهات المضادة في استغلال أعمالهم لتضييع الأهداف الحقيقية للناس.
وفى حين تمثل الاتجاهات الصبورة والعقلانية والانتقادية العاملة بمثابرة وبأشكال دستورية وقانونية، تحدياً حقيقياً لكل جماعة متكلسة، فإن الطفوليين يقدمون أفضل الخدمات لهذه القوى من مواقع تطرفهم وحماسهم العنيف.
إن الهجوم على شخصيات مسئولة وسياسية عامة بلغة وصور شخصية مقرفة وفردية، هي إساءة للنضال السياسي ومعانيه، فهي تلغي بهذه الشخصيات العامة المحترمة في مواقف مضادة، وتحول الاختلاف معها إلى معركة شخصية نارية وعاطفية تدفعها إلى مزيد من المواقف غير الموضوعية.
إن الساسة الطفوليين يفتقدون هنا إلى القدرة على تشريح وتحليل ورصد مواقف هذه الشخصيات، فإذا كانوا يمتلكون أية تحليلات حقيقية لمواقف هذه الشخصيات كانوا قد كتبوها بلغة موضوعية هادفة.
ولكن هم بأساليبهم هذه الشخصية التجريحية المغرضة جعلوها في محل التعاطف العام، كما تعرضوا هم أنفسهم للمساءلة القانونية، والنقد الاجتماعي والرفض الوطني! إن التصرفات الغوغائية هنا تضر التيارات التي تكون نفسها بصبر بين الجمهور، والتي تريد تحقيق إصلاحات حقيقية للجمهور عبر المؤسسات العامة، وهذه الإصلاحات لن تأتى إلا من خلال الدخول فى مختلف الأطر البرلمانية والبلدية والنقابية والصحفية والاجتماعية لكي تجعل من أهدافها مقبولة للمجتمع.
إن نفاد الصبر هنا، واستخدام اللغة النابية الشخصية تعبر عن العجز عن الفعل السياسي الناضج، واستخدام أساليب مضرة وغير مثمرة، تؤدي إلى المزيد من المشكلات.
وهذا ما قامت به التيارات الطفولية عبر تاريخنا السياسى من تهجمات شخصية ومن طرح أساليب نضالية غير معقولة، وإعادتنا للوراء دائماً، في حين كانت الصفوف تتجمع والطاقات تشحذ.
إن التحدي الأكبر لهؤلاء هو العمل داخل الأطر الممكنة، وتجميع صفوف الناس، وخلق تعاون واسع بين المجموعات السياسية على مختلف أشكالها، تحقيقاً؛ لإحداث تحولات ملموسة في حياة الجمهور ولمطالبه.
إن نفاد الصبر لدى مجموعات معينة، تستدعي من الجماعات المرنة والعقلانية تقليل الأضرار ما أمكن وتفويت الفرص على المتصيدين في الماء العكر، وعزل ومحاصرة هذه المجموعات الطفولية وترشيد خطواتها السياسية، فليست هي بأعدادها القليلة وحدها المعبرة عن الجمهور.
وهذه الأخطاء من جهة أخرى فرصة لتشكيل قيادات سياسية مغايرة مسئولة ودقيقة ونافذة في الحياة ومشكلاتها، بحيث تعبر عن ما هو موضوعي وعام، ومجمع للصفوف، وموحد للوطن، وليس ما هو ناشز وفردي ويعبر عن خصومات وأحقاد شخصية ليس ميدان العمل السياسي الوطني هو مكان تفريغها. إن شخصيات ناقدة وطنية ومعها حشود من الأرقام والحيثيات والأدلة وبرامج العمل الجديدة والمشروعات، هي التي يحتاجها العمل السياسي والبرلماني بدرجة خاصة، ولا نحتاج لشخصيات ليس لديها سوى الشتائم والسباب!
February 16, 2024
العلمانية وحقوق المواطنة : كتب ـ عبدالله خليفة
تتعارض حقوق المواطنة مع الدولة المذهبية أو الدولة الدينية، ففي الدولة القائمة على دين أو مذهب، هناك المسائل الحقوقية الكبرى المترتبة على هيمنة المذهب الفلاني، وبالتالي فإن المنتمين إلى مذهب مغاير يكونون بالضرورة في مرتبة حقوقية أدنى.
وعلى الرغم من رفض الدول الإسلامية هذا الوضع رسمياً فإن الحياة الضمنية المتوارية شيء مختلف.
ولا ينظر المثقفون والسياسيون والحقوقيون في العالم الثالث إلى هذه المسألة الجوهرية، وبالتالي فإن مسألة المذهب السائد سياسياً، قد أصبحت مشكلة حقوقية إضافة إلى أنها عائق لتطور الوحدة الوطنية والتعددية السياسية والاجتماعية.
والمذهبية السائدة وحقوقها المتميزة مخالفة للإسلام شرعاً، حيث إن أمة الإسلام حسب وعي الشرع أمة واحدة، والمذهبية السياسية من البدع التي حدثت في القرنين الثاني الهجري والثالث.
ولهذا فإن العلمانية الإسلامية هي الجائزة والمقبولة فقهياً وسياسياً، حيث تغدو الدولة بلا مذهب سائد، وبلا مذاهب مخالفة، فلا يسأل المواطن عن مذهبه إذا أراد أن يصدر جوازه، أو حين يريد أن يدخل الجيش أو حين يرشح نفسه في دائرة انتخابية، وكل من يسأله يتعرض للعقوبة.
وبهذا يجد المواطن المسلم أو المسيحي نفسه حراً، وتجد الدولة نفسها حرة من المذاهب السياسية، ولا يجد الطلبة أنفسهم مجبرين على تعلم مذاهب لا يريدون تعلمها. وتصبح حصص الدين اختيارية.
ويجد المواطنون أنفسهم كمواطنين وليس باعتبارهم سنة أو شيعة أودروزاً أو مسيحيين أو موالك أو شوافع أو غيرذلك من صنوف المذاهب التي صارت حكومات ودولاً، بدلاً من أن تكون فتاوى مدنية لأسئلة الحياة.
تحرير الأديان من هيمنة واستغلال السياسيين، تجعل الملا يتحول إلى زعيم مدني، ترفض الدولة أن يستغل الدين في دعايته السياسية، بل تطالبه بأن يوضح برنامجه الاجتماعي والسياسي، وان يحدد الطبقة أو الفئة التي يعمل من أجل تطوير اوضاعها، وان يدع الكلمات الدينية المجردة، وبهذا يتم التعامل معه كمسئول ساسي مُحاسب من قبل ناخبيه، وبهذا أيضاً ينقذ المذهب الذي ينتمي إليه من المسئولية السياسية التي قد تسببها أعمال السياسي المذكور.
وإذا قام المذكور بأعمال إجرامية روج لها تحت اسم الدين أو المذهب، فإن العواقب تكون وخيمة ليس عليه فقط بل على المنتمين إلى الدين أو المذهب الذي ينتمي إليه، والذي زعم إنه يعمل تحت رايته وهداه.
إن تفكيك العلاقة بين المذاهب والسياسة لن يضر المذاهب بل سيفيدها، وسيكون أكبر النفع على المواطنين الذي سيتحدون، كشعب واحد، وبالتالي ستتطور الأمم الإسلامية لتصبح أكثر قوة ووحدة وحرية.
إن العلمانية تكون في المستوى السياسي فحسب، أي ان المواطنين متساوون أمام الدولة اللامذهبية، في حين ان حياتهم الاجتماعية هم أحرار في تطبيق الأحكالم الشرعية التي يريدونها.
وبهذا فإن الدول الإسلامية تنسجم في سياستها وقانونها، فلا تغدو ثمة مذهبية سائدة، أو مذهبية مغلوبة على أمرها ويغدو المواطنون على درجات، بل على درجة واحدة.
وسيحرر هذا الفئات الوسطى والعاملة من الانقسام ويوحدها في تشكيل المجتمع الحديث من مواقعها المتميزة.
February 5, 2024
لا يقرأون . . ويتعاظمون! : كتب ـ عبدالله خليفة
ضيعة الكتب ضيعة كبيرة.
أصدقاء الكاتب لا يعرفون عناوين كتبه.
بالكاد تجد مواطنين في المكتبات المحلية ويتفضل الزوارُ القادمون من الخارج بشراء الكتب المكدسة.
مجلات كتب حديثة وإنتاجات مهمة لا تلامسها الإيدي.
ما هي أسباب هذا الجهل المستفحل؟ لماذا يتجنبون الكتب والعلوم والثقافة ثم يهرلون للقيادات ؟!
أحاول أن أجد خصباً فكرياً على كل سنوات التجربة القاسية والطويلة لكن الكتب القليلة تأتي ضحلة، أو مناوئة للحداثة والتغيير الديمقراطي الكاسح في العالم. ويعود القاص الشاب إلى ما كان يُكتب في الأربعينيات من القرن الماضي. وقد حدثت ثورة إبداعية في الوطن العربي.
الجمل السياسية والفكرية لا تزدهر بالنتاجات ولا تتأثر بهجوم الراوية في العالم، ولا بثورة الثقافة العلمية، دائماً هناك العودة للمسائل والمحنطات السائدة والاستهلاكية المكرورة.
من المؤكد أن الحركات الدينية المحافظة الغريبة عن العقلانية الإسلامية، لعبت دوراً في العودة للوراء واكتساح وهج العقول النقدية، لكن هذا لا يفسر هذا الوباء كله.
إنها تعادي الرواية والشعر والفنون الحديثة والقراءات الجديدة في التراث، لكن ماذا عن الأحجام عن الكتب الدينية نفسها؟ وحتى المكتبات الدينية التقليدية تبدو خالية مقفرة من البشر!
ثمة أسباب أعمق من ذلك. بطبيعة الحال هناك الكسل والخمول، ولكن لماذا يشتري أولئك القادمون من الخارج بشكل واسع من مكتباتنا وهم يعيشون نفس الظروف العامة؟
يقول مشتغل في مكتبة: لولا الزوار القادمين من العربية السعودية لأغلقت مكتباتنا!
لماذا يحلل كتابٌ ونقادٌ عربٌ ما يكتبه المؤلفون البحرينيون وهنا ليس ثمة متابعة أو حتى تعليق على ما يُكتب؟
كم من المطبوعات نزلت ثم لا تثير شيئاً. هنا حالاتٌ من العداء واللامبالاة والاستخفاف والاحتقار لما هو وطني، كأن ثمة ترصد عدائي، ورعب من أي جديد في الكلام المحلي.
هشاشة المعسكرات السياسية تنتقلُ للأدمغة المتجمدة.
وبطبيعة الحال فإن المعسكرين المتصارعين في ساحة المشرق يدلان على ضحالة التفكير، ويشبه ذلك ما حدث في القرن التاسع عشر من صراع بين الدولتين العثمانية الفارسية. فكيف قادنا التفكير السياسي الطائفي للتراجع الفكري والعودة للعتيق؟
وحلقات الاتجاهات وعمليات النفخ السياسية المتشنجة مرتبطة بالقراءة والثقافة، فهي بحاجة دائماً للشحن نظراً لضيق أفقها، فهي لا تثق بالجمهور الحر، وبعقله المتفتح وتوجهاته للكتب المختلفة. وخاصة إن ذلك انعكس حتى على الصحف والحياة اليومية العادية!
حين يسمعُ السياسي الشمولي إسماً من غيره جمعيته الكونية يسحبُ مسدسَهُ ويطلقُ النارَ!
لماذا الآخرون القادمون من الخارج تصلهم الشحنات الكهربائية ويحبون الكتب وهنا لا تنفد من بين الصخور؟
هل أدت بعض الحريات السياسية إلى المزيد من السير الفكري للوراء؟
هل العراك على الكراسي والفتات يجعل الناس يزدادون أمية؟
لماذا تجري احتفالات وهيلمانات من أجل الثقافة الأجنبية ثم حين تقترب من الثقافة الوطنية تتجمد وتتبخر؟
هل هو حقدٌ أم خوف؟ أم هو مثل قول القائل: (أكره أن يصير أحدٌ من بني وطني كبيراً)؟
لماذا يقزمون ابناءَ البلد وخاصة المنتجين؟
لماذا انتقل هذا الوباء من الأجهزة الرسمية للأجهزة (الشعبية)؟
هل إن البلد الصغيرة صغيرة في العطاءات وأعداد المثقفين والقارئين وكثيرة بالمشاغبين والعاطلين والنائمين؟
لعل من الأسباب المهمة في هذا المجال، هموم الرزق، فقد تدفق أهل الريف على المدن من أجل العيش، وقد حبستْ التوجهاتُ المحافظة العقول عن تجاوز حد نصوصي معين حتى لو كان مذهبياً من أهل القربى، وهذا أمرٌ يحجر على العقول ويمنعها من أبسط واجبات الحياة وهي القراءة.
وقد تضافر مع هذا المنع من التفتح صعوبة العيش، وتدني الأجور وتضخم الإيجارات وارتفاع الأسعار ومزاحمة الأجانب على عيشنا في بلدنا، فكأن الجهات جميعاً تتفق على أن لا يرفع هذا الإنسان البسيط رأسه، أو يستريح قليلاً من هرولة الرزق، لكي يقرأ ويتفتح، ثم يُطالب بأن يكون مرناً غير فوضوي وعقلانياً وديمقراطياً!
فهل تأتي العقلانية من الهواء؟
وحتى عندما يسير لوظيفته أو تسليته يحتاج زمناً طويلاً لكي يسير في الشوارع المزدحمة بسبب غياب الخطط الاجتماعية والمرورية، فيقضي هذا الوقت في البحلقة، وتسخين الأعصاب، وليس لديه جريدة أو كتيب للقراءة، يستثمره في هذه الساعات النهارية الطويلة متجمداً وراء مقعده!
الغربيون يستغلون الأوقات الطويلة في القطارات لقراءة الكتب الشعبية والجرائد.
كما أن هجوم الريفيين الأجانب عامل آخر في هبوط العلوم والاندفاع في أعمال الرزق الصعبة، فهم يحملون كميات كبيرة من الأمية والتضاد مع المجتمع، ولا يشترون كتباً ولا يقرأون سوى جرائد قليلة باللغات الأجنبية.
أغلبية المجتمع من الأميين والأميين الثقافيين، مع أزمة قراءة عربية، والمؤلفون العرب والمترجمون يسكبون دماءهم في أسواق شبه خاوية. وهناك إنتاج عربي هائل من الكتب ومع هذا فلا يُقاس كله بإنتاج دولة أوربية واحدة كأسبانيا.
وصار السوق هو المسيطر، ولأن وعي الجمهور تدهور فقد ظهرت كتبٌ تعكس هذا التدهور العقلي.
قلة الثقافة تؤدي إلى جمود السياسة، فلا يغدو ثمة حراك عميق في أذهان الجماعات السياسية، لأن محدودية المعارف والرؤى تجعلها لا تفهم الحواجز المفتعلة بينها، فتحتاج سنوات كثيرة لعبور شعرة سياسية واحدة.
January 26, 2024
الدينيون واللادينيون : كتب ـ عبدالله خليفة
أخلاق التغيير
«أدبني ربي فأحسن تأديبي»، حديث شريف .
حين يسمعُ الإنسانُ العامي البسيط هذا الحديث الشريف يخيل إليه أن ثمة مدرسة إلهية علوية هي التي قامت بتغيير سلوك النبي (صلى الله عليه وسلم) فحولته في طرفة عين من حال إلى حال .
ويروى في العلم القديم أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قد جاءه ملكان وشقا صدره وغسلا قلبه بثلج وكأن هذا كان تطهيراً وغسلاً وتربية كلية أبدية .
ولو كان ذلك كذلك لما احتجنا إلى المعاناة النبوية والبشرية عامةٌ، أو إلى المرحلة المكية والمرحلة المدنية، وإلى الحروب وقطع طرق القوافل والغزوات وتثقيف البشر والصراعات المضنية .
وهكذا فإن التربية مدرسةٌ أرضية، ومعاناة وآلام، ونزول إلى المعلمين وصعود بثمار التربية، لتكون مدرسة للعالمين .
والأدب هو لغة تعني خلق حسن الأخلاق عند الإنسان، والأخلاق لا تنشأ في فضاء مجرد، ولا في صحراء خاليةٍ من البشر والحيوان والكائنات بل هي تظهر لدى الإنسان حين يعامل الآخرين بالحسنى واتساع الصدر والحب، ولكن الأخلاق الرسولية التي وضعت في بالها تغير حال الإنسان من عصر إلى عصر، تضيفُ إلي هذه الأخلاق الطيبة لدى أواسط الناس شيئاً كثيراً من التضحية ومن الغوص في المعرفة.
فأخلاقها لا بد أن تحتك بالكريم والوضيع والمنافق والدساس والطيب، وتنزل إلى الأسواق تدعو، فيجابهها خصومٌ عتاةٌ، وعامةٌ ضائعة في البحث عن أرزاقها، ولا بد أن تقول كلمتها أمام الجميع، فلا تداهنَ المنافقَ وتحبُ الفقيرَ الجاهل لكي ينتبه، ولا تحابي الغني المغرور الذي يريد أن يشتري الدعوة بأمواله .
إن النزول إلى الشوارع والأسواق والدعوة بين العبيد والحرفيين والتجار، يجعل الذات المنعزلة تنصهرُ في معمل التغيير، فأي غرور فيها يصيرُ تواضعاً، وأي انعزال داخلها يصيرُ مشاركةً، وأى غضبٍ لديها يصير حلماً، وأي جهل عندها يتحول إلي علم.
والنبوةُ الكريمة العالية المغسولة بمعنى الإله تُغسل بماء الناس، وعذابهم وبحثهم عن سبيل للتغيير من حبس الأشراف واستغلالهم، ومن تفرق القبائل وتشتتها، وحروبها الجاهلية «العقيمة»، ومن ضياع القادة في أنانيتهم الشخصية، لكي ينصهروا في التحول الكبير.
إن كل هذا يتحول إلى حركة تاريخية تدخل من الأمور الصغيرة إلى عظائم التاريخ ومسرح التغيير العالمي .
ولا بد لكل قائدٍ من عالم خاص تجب مراعاته وتغيير سلبياته، ولا بد لكل زعيم عشيرة من مصالح مؤقتة يحسبها هي كل الوجود، وهناك زعماء الاديان الذين حبسوا في تفاسير قديمة، ولا يرون آفاق التغيير الراهن الوفيرة بالخير.. وكل هؤلاء المحنطين في ثيابهم العتيقة وحفرهم الضيقة لا بد من مراعاة أوضاعهم الخاصة لكي يخرجوا منها ويروا ما هو عام وعظيم!
إن النبوة مثل مدرسة كبرى في تغيير العالم العتيق تصهر ذاتها في فرن هائل ومن نتفٍ من الشخوص ومن لمعات من الأخلاق والضوء ومن قادة يظهرون من بين الأميين تتشكل أخلاقٌ جديدة .
إن البساطة، والتواضع، والمحبة، والصلابة، وفعل الخير، وحب الحياة، وعدم الخوف من الموت، والشجاعة، والعمل للآخرين وللعرب وللبشرية الخ .. هي الأخلاق التي تكونت في زمن التغيير النبوي لكي تكون ميراثاً لمن يريد أن يغير ويضحي ويكتشف سبلاً جديدة للأمه.
الدينيون واللادينيون
أسوأ الناس هم الذين يتاجرون بكتاب الله وكلام الله ليصلوا إلى أغراضهم الدنيوية، ليجمعوا العقارات والأسهم ويشيدوا المباني التي تنزل على رؤوس الفقراء إيجارات باهظة.
إنهم يرددون كلام الله ليتاجروا في دماء وعظام المسلمين، لا تأخذهم من كلمات الله خوفاً أو خشيةً من عقاب أو تفكير في ثواب!
وربما أفضلهم هؤلاء اللادينيون الذين لم يؤمنوا ولكنهم يخشون الحرام فيدافعون عن الفقراء ولا يفكرون بدينار واحد يسرقونه من فم امرأة عاجزة ويتيم، جحدوا بالآخرة فانصفهم الله!
الدينيون الذين جعلوا من كلمات الله تجارةً، فتسلقوا المناصب والمباني الطويلة في فساد السياسة، وأثروا على حسب القرآن، ويرددون كل يوم أحاديث الرسول المصطفى وآيات الله وهم لم يدخلوا زقاقاً يسكنه فقراء، ولا نضحت كلماتُ النفاق لديهم بالضرائب الباهظة على كواهل المتعبين من الرجال والنساء، ولا لمسوا دمَ سجينٍ تكهرب جسدُهُ من سياط المعذّيين، ولا تصدوا لرصاص ينطلقُ على عمال مضربين لأجل دراهم زهيدة، ولا وضعوا كلماتهم، ولا نقول أجسادهم، لتقف دون بلدوزات تهدمُ بيوتَ الفقراء لتؤسس ناطحات سحاب للأرباح الصماء.
هناك من الدينيين من يفكر فى الثواب والعقاب، ومن امتلأ ضميره بخشية الله، فتراه مسكوناً بالبحث عن الحق والحقيقة أين يكونان، لا تهمه خرائط الجغرافيا البشرية، ولا ألوان المعذبين ولا جلود الممزقين، لكن تكفيه آثار الحوافر في الجلود، ويرتعش ضميره بالخوف من بضعة دراهم أخذها وهي له، وإذا حكم ووضعت أمامه خزائن الأرض سلمها لمن لا فلس عنده، ومن تنغرز أقدامه في السبخ الملوث بالشوك وخناجر المكوس..
التجارُ بكلمات الدين والإلحاد والصوفية والثورة والليبرالية هم أنفسهم، طلاب المنافع، والتسلق على ظهور الآخرين والصعود على الضحايا والآلام، هم أنفسهم الذين يبيعون أقرباءهم وأمهاتهم في أية لحظة كساد في الجيوب، هم كلهم الذين يتعاونون على وضع القيود واستغلال الناس وبناء عمارات العذاب.
لن تتخلص من سكاكينهم في روحك إلا إذا نزعتها من مهرجانات الأنا، وحب الذات، ومشيت على شوك التضحية والبساطة، وجمعت بين كفاح الأنبياء ونضالات الفلاسفة، بين نضال المؤمنين الذين تخلصوا من حب الكنوز، ونكران الذات لدى اللادينيين الذين تمردوا على عبادة الفرد، وأخلصوا للحقيقة من أي جهة يجيء بها الهواء النقي والوعي غير الشقي.
بوصلة الحقيقة تكمن ريشتها الدقيقة في مساكن الفقراء وأجور الضعفاء كيف هي وإخلاص الأغنياء للوطن، ودعم الإنتاج ورفض البذخ وسرقة المال العام سواء أكانت لدعم اتجاه ديني لضرب الديمقراطية، أم دعم اتجاه علماني لكتم الأصوات ، وأما التعاويذ والقراءات اللفظية والجعجعات الموسمية فهي كلها تجارة لأناس باعوا أرواحهم لمن يدفع.
وكلما سمعنا منادياً يتاجر بكلمات الإله تساءلنا ماذا أخذ وماذا أعطى، فإذا كان يدافع عن الناس لأنه يتصدى للعمل العام، قلنا إنه رجل فاضل، وأما إذا كان يريد توسيع تجارته وضم بنايات جديدة إلى بناياته، قلنا انه كاذب يتاجر بكلمات الدين فهو أسوأ على الدين من الملحدين النفعيين!
لابد من التفرقة بين من يمارس التجارة باسم الدين، ومن يمارس التجارة إصلاح الدين والمجتمع ، فمن يتاجر بالدين وصل إلى الدرك الأسفل، والخطورة هي في ظهور الأدعياء بمطهر الدعاة، وسيطرة الفساد على مواقع البث الإيماني، وعملية الخلط بين السام والسامي، وبين بيع الزهد بالزهيد، وشراء العرض بدل العريض، وتقريب التافه لا الثمين.
إن معيار الصدق هو التصدي للفساد والاستغلال البشع وهو معيار رفضه الدينيون واللادينيون الانتهازيون!
المؤمنون واللا مؤمنون
كان الإيمان في صدر الإسلام مرتبطاً بمضمون اجتماعي مطابق له، فالمؤمن مدافع عن الدولة الشعبية التي توزع الخيرات بين المؤمنين بالعدل، لكن حين أصبحت الدولة الإسلامية مضادة لهذا التوزيع وللتعبير عن الجمهور الشعبي، التبس الإيمان!
لهذا غدا الإيمان عند متخصصي السياسة والمتعهدين في استثمار تضحيات الناس، تجارةً.. وهذا قد بدأ عند مؤسسي حكم الأسر، الذين كانوا يريدون أن ترث قبائلهم وأسرهم لحم الناس وتبيعه في السوق.
ولهذا لم يكن عهد النبوة وعهد الخلفاء الراشدين عهد تجارة بالدين والإيمان، بل عهد تأسيس للحضارة الإسلامية بشكل التضحية والتعاون.
ومن هنا غدا الإيمان عند أغلبية الطبقة الحاكمة والسياسية والدينية بعد ذلك تجارة، وهو لا إيمان عميق، فغدا الحكم اللصوصي وتوزيع الغنائم على المتنفذين إيماناً، وهو لا إيمان وعدم إقرار بالثواب والعقاب، وعدم خوف من عقاب الله، وتجريد الإسلام من أحكام الضمير والجنة والنار، وتسويق ذلك كدعاية للعوام من أجل السيطرة عليهم، واستغلالهم.
وسوقت ذلك طوائف من رجال الدين، وفصمت الإيمان عن الممارسة السياسية العادلة، وعن سرقة أموال الناس، فيمكن أن «تؤمن» ولكن تستطيع أن تتحول إلى جزار ولص وانتهازي، والمهم هو أن تقول كلمات وتؤدي حركات، لكن ضميرك الداخلي غير موجود!
ولهذا كان الحجاج بن يوسف الثقفي يعتبر نفسه مؤمناً رغم أنه يجثم على سجن به عشرات الآلاف من المعذبين والموتى!
وكان المعذبّون بعد أن يسلخوا جلودَ المناضلين يتوجهون للصلاة!
وحين نشأت الحركاتُ الوطنية والديمقراطية الحديثة ورأت هذه المجازر الفكرية، ظهر اللا مؤمنون الرافضون لذلك الإيمان، والمنكرون لله واليوم الآخر والثواب والعقاب، باعتبارها ضلالات الطفولة الفكرية، وليس باعتبارها ميراثاً عميقاً لشعوب، اعتبرتها نظاماً سياسياً لا يفصل سلطة الشعب عن توزيع الخيرات بشكل مشترك، ويجعل خدمة الناس جزءاً من الرقابة الإلهية عليه!
ولكنهم إنكارهم تلك المثاليات الغيبية، عملوا على تجسيدها بدمائهم وفي النضال الملموس بين الناس!
فلم يمارسوا سرقة من المال العام، ولم يتواطأوا مع الأجنبي المحتل، حتى جاء وقتٌ تحولت التجارة بالدين إلى شكل واسع، وشعر الكثير من المؤمنين واللا مؤمنين بأهمية التجارة فى الدين، والاحتيال فيه!
فغدا الانتهازيون من الطرفين يدركون اهمية التجارة برموز الإسلام، وخداع المؤمنين، للحصول على مكاسب مادية، وليس لفضح ونقد الأوضاع العامة السلبية التي يعانيها الجمهور، والدفاع عن المال العام..
وغدا هذا التوحد الانتهازي استثماراً خطراً على الفريقين، فالفريق «المؤمن» يعرض نسيج الدين للخطر، ونسيج الدين هو ميراث أجيال طويلة، ويعبر عن هوية وجودها وتميزها بين الأمم ومقاومتها عبر العصور، والتقدمُ يجري من خلال تطوير هذا النسيج، وليس بتمزيقه!
فهذا الاستثمار ينشرُ اللا إيمان به، حين يحوله إلى سلعةٍ رخيصة، ويشكك الناس العاديين في قيمه التاريخية، فلا يفترق هنا الحجاج بن يوسف الثقفي عن أي زعيم من هؤلاء، يعرض حياة الناس للخطر والموت بإدعائه تمثيل الإسلام وحده أو مع جماعته المميزة أو تحويله الإيمان إلى حصالة لجيوب المنتفعين!
والصراع مع هؤلاء إنقاذ للإيمان قبل كل شيء.
وحين يغدو اللا مؤمنون مؤمنين بحسب بورصة الانتخابات والحلم بالكراسي، بعكس أن يشكلوا اقتراباً موضوعياً من الإسلام باعتباره ثورة نهضوية توحيدية، لا تحتاج إلى بخورهم وتعاويذهم المفاجئة واحتيالهم!
وباعتباره الطريق الأسهل للهبر من لحم البسطاء والعاملين!
فهذا يعني أن اقترابهم من الإسلام هو اقتراب تضليلي، يشارك في تمزيق نسيج الإسلام كما يفعل خصومهم الانتهازيون اليمينيون، وهنا تغدو الجهات أكلاً من الذبيحة الشعبية من جهات متعددة!
فلا اعتبار للثواب والعقاب ولا اعتبار للضمير ولكن هي المصالح الشخصية وتكديس الثروة!
وبما أن الجمهور غافل فهي فرصة، فلا رقيب ولاحسيب!
قراءة في وعي علي شريعتي : كتب ـ عبدالله خليفة
ولد المفكر الإيراني علي شريعتي سنة 1933، وكان والده رجل دين مثقف ، ومؤسساً لمركز فكري .
ورغم كونه من شريحة متوسطة فقد كانت نشأته بين الفلاحين والفقراء ، فتشبع بمعاناة شعبية مريرة .
وقد نشأ في ذلك الخضم من التحول الوطني في إيران ضد الهيمنة الأجنبية . كان تأثير والده كبيراً عليه ، فاستمر في مشروع مركز والده الفكري ، لقراءة الإسلام ، وقد أرسل إلى بعثة دراسية بالمصادفة إلى فرنسا ، وهناك أعاد بناء ذاته الثقافية ، يقول عن هذه الفترة :
( وبين فجوة من جدار الجامعة يقفز إلى داخلها بل وفجأة يجد نفسه في قافلة تحمل أولاد الأشراف ومدللي المملكة وزبدة البرجوازية الجديدة في المدينة وأحياناً أولاد خانات الإقطاع الذين أصبحوا عصريين إلى مراكز الحضارة والثقافة والقوة والثروة والصناعة واللهو والقصف في العالم) ، ( 1 ) .
هذه اللغة الأدبية ، المُضفرة بين التحليل الطبقي والحس الشعبي والإيمان الديني ، ستكون دائماً أداةَ شريعتي في قراءةِ العالم ، وهي تعودُ هنا إلى مرحلة التداخل بين العلمانيين الإيرانيين والدينيين ، في ذلك الغبش الذي يسبقُ الافتراق بينهما ، والذي يحضر لعملية التغيير الثورية لنظام الشاه .
في أوربا أضطلع شريعتي بتأسيس فرع حركة تحرير إيران التي أسسها كل من آية طالقاني ومهدي بازركان ، هذه الحركة الممثلة للبرجوازية الوطنية الإيرانية الليبرالية و الدينية .
هذا التداخل بين الدين والليبرالية ، يتجسد هنا في الجمع بين طالقاني وبازركان ، طالقاني الديني والقريب من الليبرالية ، وبازركان الليبرالي القريب من الدينيين، وهي علاقة كانت معبرة عن ذلك التداخل بين التجار ( رجال البازار ) والقوى الدينية .
ولن نجد تجسيداً فكرياً لهذه العلاقة خير من علي شريعتي نفسه ، فهو الذي يحمل وعي رجال الدين وقد ألتهب بروح التحرر ، وهذه المداخلة بين الدين والحرية ستكون قضيته ، فهو يجعل الدين بوابة للحرية ، وهو يحرر الدين من العبودية ، وهذه النضالية المزدوجة ، هي مرحلة جنينية في الوعي الوطني الديمقراطي الإيراني وهو ينمو داخل النظام الإقطاعي طالعاً إلى العصر الحديث .
ولهذا فإن كلَ قوى الجبهة المعادية لنظام الشاه سترى في علي شريعتي مثقفها ، وصوتها ، لأنه يحمل هواجسها وبراعهما الفكرية ، لكن دراسة شريعتي بشكل موضوعي ستكون مسألة أخرى .
أعطت المرحلة الأوربية لشريعتي صلاته العلمية والسياسية مع أبرز مثقفي العصر ، ومع الحركات التحررية في ذلك الوقت ، كجبهة التحرير الجزائرية التي دافع عن كفاحها ، وساعدته بعد أن وصلت للسلطة للخروج من سجنه في إيران .
بعد رجوعه إلى بلده عمل شريعتي في التدريس ، وفي هذه السنوات القصيرة ألف أبحاثاً كثيرة ، وأشاع وعياً جديداً في إيران ، لقى على أثرها مصرعه .
يمثل منهجُ علي شريعتي الفكري رؤيةً دينية مسبقة تقوم بمعالجة الوقائع التاريخية والفكرية من موقفها الديني ، فهو يرى إن الدين التوحيدي ( يقوم على أساس عبادة رب واحد والإيمان بقوة واحدة متنفذة في مصير المجتمعات الإنسانية على مر التاريخ ) ويضيف بأن ( هذا الاعتقاد البشري يمثل ميلاً فطرياً نحو عبادة القوة الواحدة والإيمان بالقداسة ) ، ( 2 ) .
إن شريعتي هنا يأخذ التوحيد اليهودي والإسلامي كشكلٍ وحيد للوعي الديني في العالم ، وفي كلِ مراحل التاريخ ، في حين إنه يمثل تجربة بشرية معينة ، ولها من العمر ألفين من السنين ، كما إن تجربة الإنسان الدينية على مدى مئات الآلاف تقوم على تنوع الآلهة والمعبودات والأديان والمذاهب .
وهذه المعلومات أصبحت بديهية ولكن علي شريعتي لا يقوم بدرس تاريخ الإنسان الديني المعقد ، ويقوم بتبسيطه تبسيطاً مؤدلجاً ، لكي يضعَ داخله مسلماته الدينية المسبقة ، وهذه الطريقة من البحث قد لا نراها فيما يلي من منهجيته ، ولكنها هنا تقوم على قراءة لا تاريخية للأديان ، فتلغي التوحيدَ كذروةٍ لتطور الدين في منطقة المشرق ، فحين لا ترى جذوره وتجعل تاريخ الدين واحداً ، تنفي المجاهدات والنضالات الطويلة التي تشكلت للخروج من الطوطمية وعبادة الأسلاف والأجداد وعبادة الكواكب والنجوم والأصنام الخ . .
إن هذه العبادات مثلت تطور عبادات القبائل بصورة طويلة معقدة ، في المناطق الزراعية خاصة : مصر ، العراق ، سوريا الخ . . ثم جاء الدينان التوحيديان من القبائل الرعوية التي كانت مغايرة لهذا التكوين الزراعي ، ونظراً للمهام التوحيدية السياسية التي كانت أمامها .
وتمثل هذه التواريخ مادة دراسية أولية منتشرة ، فنستغرب كيف لا يتمكن باحث كالدكتور علي شريعتي من الإحاطة بها . وبغض النظر عن المطامح الأيديولوجية المسبقة فإن للبحث العلمي موصفاته المختلفة .
لكن هذه العملية تعبر عن طريقة التجريد التي يلجأ إليها شريعتي لفرض وجهة نظر مسبقة ، وهي طريقة ستكون إحدى أداتين يلجأ فيهما لقراءة التاريخ ، أو بالأحرى في توظيفه لصالح موقفه السياسي الراهن وقتذاك .
والأداة الثانية هي شحن هذا التجريد بمادة ملموسة وحقيقية منتقاة ، وهي لا تتضاد مع ذلك الموقف ولكنها أيضاً تكشف وقائع حقيقية وصراعات موضوعية ، لأنها وليدة مادة التاريخ الحقيقي ، وبهذا تجري عملية فكرية مركبة ، فيها الحقيقي المنتقى الموظف لصالح الموقف الإيديولوجي ، وفيها القطع عن جذور التاريخ وصراعاته الشاملة .
إن الموقفَ السياسي الديني الراهن لشريعتي يحكمُ قراءة التاريخ ، وهو موقف ينطلق من ظروف إيران ومن مذهبها الديني السائد ورموزه وتاريخه ونضالاته العظيمة ومن كونه شكلاً من أشكال الوعي القومي ويعبر عن فئات وسطى في مخاض بين كونها تابعةً للإقطاع الديني ، وكونها برجوازية ، بين رؤيتها للعالم من خلال المذهب ، ورؤيتها له من خلال بعض جوانب العلم ولغة التحديث .
في المنهج وتناقضاته تناقضات الفئات الوسطى الإيرانية ، في محاولاتها لإيجاد جذورها الجديدة ، ولقراءتها المتعينة للتراث ، وللسيادة على الطبقات الأخرى ، ولتبعيتها للإقطاع وعدم قدرتها على الاستقلالية الفكرية في ذلك المخاض السياسي ، مخاض حركة تحرير إيران بقيادة رأسيها الطالقاني وبازركان ، حيث بعدُ لم يتضح الصدام بين الفئات الوسطى والإقطاع الديني ، حيث بعدُ لم يتضح القائد : الدين التقليدي أم العلم ، القرون الوسطى أم الحداثة ، الاستبداد أم الليبرالية ؟!
في منهج شريعتي هذا المخاض الفكري والسياسي .
دينـــــــــــــــــــــــــان :
في كتابه ( دين ضد الدين ) يفرق علي شريعتي بين نمطين من الدين ، نمط الدين القديم ، ونمط الدين الجديد ، فالصراع في رأيه ليس بين الدين بشكل عام ، واللادين ؛ فهو لا يتصور وجود فترة انتشرت فيها التصورات اللادينية ، فحتى الدهرية التي أنتجها الوعي الإيراني على مدى عدة قرون ، تتضاءل في تصوره وتشحبُ ، لأن هذا الوعي لا يصور التضادات بموضوعيتها المباشرة ، بل يصورها داخل قالبه الإيديولوجي ، بل بين الدين والدين ، بين الدين في سيرورته الدائبة ، باعتباره الحركة الفكرية الوحيدة في التاريخ البشري ، فكل ما عدا الدين هو شيء خارج الوعي الإنساني ، ولهذا فالصراع لا يتشكل إلا بين صورة قديمة للدين وصورة جديدة .
يظهر الدينُ بصورةٍ جديدة حين يكون ديناً ثورياً مضاداً لدين قديم محافظ يعبر عن قوى الأقلية المتميزة .
(الدين الثوري هو دين يغذي اتباعه ومعتنقيه برؤية نقدية حيال كل ما يحيط بهم من بيئة مادية ومعنوية ، ويكسبهم شعوراً بالمسؤولية تجاه الوضع القائم يجعلهم يفكرون بتغييره) ، ( 3 ) .
وهذا الدين الثوري في تضاد مع ( الدين الذي أنكر دائماً مسؤولية الناس وحقهم في تقرير مصيرهم وبرر الوضع الظالم عبر التاريخ مستغلاً بذلك معنويات الناس وشعورهم الديني القوي الخ . .) ، ( 4 ) .
يحددُ شريعتي التضادَ بين الدين الثوري الذي يعمل من أجل التغيير والدين المحافظ الذي يوقف تطور الأوضاع ، عبر لغة رغم ملموسيتها ، فهي لغةٌ مجردة ، فلا نعرفُ الأسبابَ التي جعلت الدين الثوري يختلف عن موجات الدين الثورية السابقة عبر التاريخ ، إلا بعبارات أخلاقية فهو دين زود معتنقيه برؤيةٍ نقدية ، لكن لا نعرف القوى الاجتماعية التي ظهر معها هذا الدين ، أو الفلسفة الخاصة التي شكلها ، بحيث ينتجُ علاقات اقتصادية واجتماعية جديدة ، فهو دينٌ ثوري لكنه لا يقوم باستبدال علاقات اقتصادية واجتماعية متخلفة ، بعلاقات أخرى جديدة بحيث تؤدي إلى تطور نوعي في التاريخ ، و بحيث لا يصبح كثور الساقية .
أما الدين المحافظ في تحليله فهو يبررُ الوضعَ القائم ويمثل أقلية استغلالية ، لكن لا نعرفُ أيةَ قوى وعلاقات اقتصادية و اجتماعية يعبر عنها الدين المحافظ ، فنجدُ تحليلاً ، ولكن مجرداً ، بحيث إنه يقول إن الدين الثوري يتحول إلى دين محافظ ، ثم يظهر دينٌ ثوري آخر ، في مواجهة المحافظ وهكذا دواليك دون أن يحدث تراكم وتحول يستبدل هذه اللعبة التاريخية ، فلا نعرف لماذا تستمر هذه العملية ولا جذورها الاجتماعية .
إنهُ في مثلِ هذا العرض الموجز لا يقدمُ لنا لوحةً تاريخية تجسدُ التطورات المفصلية ، لأن اللوحةَ التاريخية الملموسة المشخصة ، سوف تضعنا على التضاريس الموضوعية . فقد كانت العبادة الأولى لأهل منطقة المشرق هي عبادة الآلهة المفارقة الكثيرة المعبرة عن تلاوين القبائل والشعوب ، وحين ظهرت عبادة آلهة الخصب كتموز وأوزوريس ، كانت في مواجهة الآلهة الوثنية المفارقة ، آلهة الحكام المتسلطين ، ولكن الحكام المتسلطين والمستغلين ما لبثوا أن دخلوا في تلك الآلهة الجديدة الخصوبية وجيروها لمصلحتهم ، حتى ظهرت المسيحيةُ تتويجاً مناطقياً مشرقياً لذلك ، ومحاولة من شعوب المنطقة لطرد الغزاة الرومان ، ولكن الرومان الحاكمين صاروا مسيحيين ، وحين جاء الإسلام ليُبعد الملأ الأرستقراطي عن السلطة ما لبث الملأ أن تغلغل في الإسلام وسيطر على دولته الخ ( 5 ) .
إن اللوحةَ التجريدية التي يرسمها شريعتي لتطور الوعي الديني في العالم ، نحاولُ أن نركزها في منطقة المشرق ، وكذلك نضعها في سياقها التاريخي ، وهي إذ تتكلم عن أربعة آلا ف سنة ، توضح خطورة التفاصيل والنمو المعقد للوعي و البُنى الاجتماعية . إن هذه اللوحة المركبة لم تكن تنمو بهذه الصورة بشكلها التبسيطي ، ولكن لتطور طويل ومعقد .
إن الصورة التي يرسمها على شريعتي لتطور الدين في المشرق هي صورة تبسيطية ، فالأمر ليس صراعاً بين التوحيد والشرك على مدى هذا التاريخ الطويل ، فالموجاتُ الدينية السابقة منذ فجر التاريخ كانت غير توحيدية ومتعددة الآلهة ، والمسيحية هي ديانة ثالثوية على سبيل المثال ، واليهودية والإسلام سبق أن عرفنا جذور توحيديتهما في مواجهة وثنية مفتتة للكيان السياسي ، ( 6 ) .
إن كل ديانة جديدة لها جذور في حياة الناس لا بد أن تكون معارضة ، سواء كانت وثنية أم توحيدية ، لأن الديانة القديمة تكون قد تكلست وراحت تبرر وضعاً سياسياً واجتماعياً صار معيقاً للتطور ، ولكن القوى الجديدة بعملها النضالي لتغيير الظروف ، تستخدمُ الدينَ بأشكاله العبادية وبالغيبية الفكرية وبانتقاداته الاجتماعية ، وهذه المنظومة من العبادات والأفكار تقوم بإزاحة مستوى متخلفٍ من الوضع الاجتماعي ، لكن لا تستطيع أن تلغي الاستغلالَ ، فتجد القوى المحافظة التي عارضت الأفكار الدينية إن من مصلحتها أن تساير الموجة بل وأن تؤمن بها ، لكون الدين لم يعرض إزالتها وإزالة استغلالها ، بل هو يركز على عبادات جديدة ، أي على أشكال غيبية مشتركة بين كافة المؤمنين بها .
وهكذا فإن الدولة الرومانية لم ترفض المحبة المسيحية وأعلنت إنها دين الحق ، وقامت باستيعاب أشكالها العبادية وتعميد ثالوثها الديني ، أما جوهرها كثورة للعبيد فقد تم دفنه ، لأن المسيحيةَ لم تتشكلْ على هيئة برنامج سياسي اجتماعي محدد ، حيث كان الوعي الديني هو شكل الوعي السائد .
إن الدين هنا يعبر عن جوانب روحية واجتماعية وسياسية كثيرة ، ولكن جوهر ظهوره كثورة اجتماعية ، يتم تغييره من قبل القوى المسيطرة ، التي تتسللُ إليه بعد قوته وانتشاره ، وتتوجه إلى مضمونه وتنتزعه وتبقي أشكاله المختلفة .
ولهذا فإنه تحدث عمليات ظهور للمذاهب تقوم بمحاولة استرجاع ذلك المضمون أو تطبيق معناه الجوهري في ظروف أخرى ، وبكلمة فإن الدين يقع في مجرى الصراع الاجتماعي معبراً عن صراع معقد بين القوى المختلفة .
لكن شريعتي يضع التاريخَ في صراعٍ دائم وأبدي بين التوحيد والشرك ، وحين يطبق هذه المقولة على التاريخ الإسلامي نــُصاب بالفجيعة ، فهو يواصلُ تطبيق هذه المقولة على تاريخ المسلمين نفسه بعد أن آمنوا جميعهم به ، وهو يختار اتجاه الفقراء والمعدمين كعمار بن ياسر وسلمان الفارسي وأبي ذر ليقول إن هؤلاء هم المسلمون الحقيقيون ، في حين إن الأغنياء ليسوا هم من المؤمنين الحقيقيين والمسلمين ، بل هو يراهم مستمرين في اتجاه الشرك !
فهنا إسلام حقيقي وهنا شرك متوارٍ ، فالفقراء والمستغلون والأئمة المجاهدون معهم هؤلاء هم الإسلام ، وغيرهم غير مسلم . ويطابق شريعتي هنا بين الفقر والعذاب والإسلام ، ويطابق بين الغنى والثقافة ، بين الرشيد وأبن المقفع ، وبين الشرك واللاإسلام .
هنا يحاول شريعتي تمديد فكرة صراع الدين والشرك على تاريخ المسلمين ، بعد أن تجاوزوا مرحلة الشرك ، وهذا التمديد يذكرنا بأفكار الحركات الدينية المتطرفة في وصف المسلمين بالجاهلية والكفر ، حيث لا يتم الاعتراف بتعددية الاتجاهات الاجتماعية والفكرية بين المسلمين ، وإنهم لا بد أن يكونوا في مذهب قويم واحد ، وفي اتجاه سياسي واحد .
لكن ما هو سبب وقوع مفكر يفترض فيه أن يكون ديمقراطياً بخلق اتجاه واحد وبتكفير المسلمين الآخرين؟
لا بد أن نقول هنا إن شريعتي يستهدف المطابقة بين الإسلام والثورة المطلقة ، أي أن يقوم الإسلام في ظروفه تلك بإزالة الاستغلال والفقر ، وإيجاد مجتمع من المساواة والعدالة الأبدية ، وهو أمر خيالي .
يقود الوعي المذهبي بصورته الشمولية علي شريعتي في إنتاج مقولات العزل والإقصاء بدوافع نبيلة ، بدوافع الدفاع عن المستضعفين والفقراء ، فحين يطابق بين الإسلام والثورة المطلقة التي يجب أن تستمر مزيلةً الفقر والجوع والاستغلال ، ينطلقُ من وعي مثالي لا يضع الدين في الظروف الموضوعية التي ظهر فيها ، فالثورة الإسلامية التي انطلقت للوحدة السياسية في جزيرة العرب ، قامت على تحالف اجتماعي واسع بين تجار مكة المتوسطين والعامة وخاصة أهل البادية ، وحين حققت الثورة أهدافها في تشكيل دولة ، لم تعد تخص تحالفاً اجتماعياً مضطهداً ، بل غدت معبرة عن كل طبقات المجتمع ، الفقراء والأغنياء .
لقد تمت أسلمة المجتمع ككل ، وبالتالي كان يُفترض أن تكون الخلافات الاجتماعية والفكرية ، خارج المقولات الدينية ، وأسس الدولة ، وأن تطرح الأحزاب هوياتها الاجتماعية ، فإذا كان الخوارج يعبرون عن رعاة الجزيرة وبدوها ، فإن آخرين يعبرون عن تجار مكة أو أشراف المدينة ، ولكن ذلك لم يحصل نتيجة لطبيعة الوعي والظروف الموضوعية ، فكلٌ يقول بأنه الإسلام الحقيقي ، وغيره خارجه ، وهكذا تنامت عمليات الصراع الاجتماعي والقومي عبر المقولات الدينية الشمولية ، التي يريد شريعتي استمرارها بعد كل هذه المحن والدروس .
كانت المشكلةُ هي الإيغال في التميز الديني ، ففي المرحلة الأولى كان الاعتدال الديني سائداً ، نظراً لغياب نظريات التكفير ، ولكن ظهر أناس قلة يعتقدون إن الأمويين وبعض الأسر الغنية في الحجاز هم كفار ، وخارجون عن الإسلام ، بدلاً من أن يقولوا إنهم حكام ظالمون ومستغلون ، لكن تلك القلة ، وشريعتي يواصلُ نهجها ، اعتبرت هؤلاء المستبدين المستغلين غير مسلمين ، فكان لا بد من التطرف في الدين ، والتمايز الشديد عنهم ، بحيث كان الإيغال في التعصب هو الموجات التالية .
وهذا ما استفاد منه المسيطرون في كل طائفة وجماعة ، حيث تدعي كل واحدة منها ، إنها تمثل الإسلام ، ويقوم أربابُ هذه الطوائف بخلق الأسيجة حولها ، وشحنها بالتعصب والمظاهر العبادية المتميزة ، وشريعتي نفسه يقول :
(.. واليوم لجأتُ إلى بيت فاطمة المهجور هرباً من أولئك الطواغيت وتلك القصور والمعابد والخزائن فوضعتُ رأسي على جدار هذا البيت ولم يخدعني منذ ألف وأربعمائة أي كافر ومسلم فان في هذا البيت فاطمة وعلي والحسن والحسين وزينب.
إلا أني أرى قوماً جعلوا من هذا البيت حانوتاً لمصالحهم وجعلوا من هذه الكعبة – القبلة التي حررتني قبل خمسة آلاف عام من الرق والجور والجهل – قاعدة للجور والجهل .) ، ( 7 ) .
وهو يقول أيضاً: ( نعم ، لقد لعبت الأديان الرسمية دائماً دوراً طبقياً قذراً ضد الناس والإنسانية ولصالح الطبقات الحاكمة) ، ( 8 ) . وبما أن المذاهب الثورية تتحول إلى مذاهب رسمية ، فتقوم بهذا الدور ، فكيف السبيل إلى الخلاص ؟ كيف نعيدها إلى إنسانيتها دون أن نفصلها عن السلطة الرسمية واستغلال الناس ؟ !
إن شريعتي وهو يفصلُ الثورةَ عن الإنتاج المادي ، يعلقها في فضاء ديني مثالي ، فكيف يمكنُ تطويرَ المجتمع العربي الإسلامي الأول دون نمو التجارة والحرف وبالتالي نمو الاستغلال ، لكن أية أشكال من الاستغلال يمكن أن تكون مغيرة ومحدثة للمجتمع ؟
لقد اتجه العربُ والمسلمون إلى الاستغلال السهل : الفتوحات والاسترقاق وعبودية النساء ، بدلاً من تطوير الحرف والمصانع والعلوم ، وحتى هذه ارتبطت بهيمنة الدول الشمولية على الخراج وإضاعته وتبذيره في المتع والترف الخ . .
أي أن القوى الاجتماعية المتضررة لم تقم بالتوحد وجعل الموارد الاقتصادية موجهة للإنتاج والعلم وللحاجات الطبيعية والعامة ، وهكذا فإن الاستغلال الزراعي ومساربه نحو البذخ ، وليس إلى تطوير الحرف والعلوم ، هو الذي قاد المسلمين نحو التدهور المذهبي والسياسي ، ولو كان استغلالاً صناعياً ، لكان الأمر مختلفاً .
ألم يكن ذلك من مسئولية الفرق الدينية ، التي وجهت نشاطها إلى المزيد من الغيب والعزلة ، بدلاً من أن توجه وعيها لنقد الحياة وتوجيهها نحو التحديث والتصنيع والعلوم ؟ !
ككل الشموليين العرب والدينيين يرفض علي شريعتي المرحلة الرأسمالية ، رغم أطروحاته الموضوعية في فهم الحداثة ، وتقديره لإنجازاتها ، بخلاف ما هو شائع لدى الدينيين .
فهو يقول : ( إن الرسالة التي حملها المفكرون الأحرار في أوربا في صراعهم مع دين القرون الوسطى والتي أنقذوا فيها أوربا من التخلف والرجعية هي الرسالة نفسها التي أخذها أنبياؤنا على عاتقهم عبر التاريخ) ، ( 9 ) . وبطبيعة الحال ، فإن شريعتي هنا يعطي معايير مزدوجة للدين وللعلمانية ، فرغم إنه هو نفسه يعترف بأن الأديان والمذاهب في المشرق تم استغلالها من قبل الحكام والقوى المحافظة ، إلا أنه يرفض أن يلعب دور المفكرين الأحرار الذي حدث في أوربا ، عبر فصل الدين عن السياسة ، ولتوقيف ذلك المسلسل الذي كشفه بنفسه ، وهو مسلسل استغلال الدين من قبل القوى السائدة .
فإذا كان التاريخ الشرقي قد استمر يستخدم الدين طوال أربعة آلاف سنة ، ودائماً كان يتسلل الاستغلاليون إلى الدين ويعيدون صياغته لمصالحهم ، رغم تضحيات الأنبياء العظام والأئمة الشهداء والكثير من المناضلين والدينيين المخلصين ، فلماذا الاستمرار في هذا المسلسل ولماذا لا يحدد الدينيون أنفسهم كسياسيين منفصلين عن القداسة الدينية ورموزها ، ويطرحوا برامجهم الاقتصادية والاجتماعية ، بدون تعكز على السلف الصالح ؟ !
فإذا نجحوا في برامجهم السياسية فسيكون ذلك نصراً لتيارهم الديني ، وإذا فشلوا واستغلوا مناصبهم فسيقع ذلك على أشخاصهم .
إن شريعتي لا يطرح ذلك أبداً ، لأن منهجه مصمم على استئصال الآخر ، أي على صراع الإيمان ضد الشرك ، وهو أمر يقوده إلى الصراع مع المسلمين أنفسهم ، بدلاً من أن يبرمج هذا الإيمان ، أي يقول ماهية أهدافه العملية في الاقتصاد والسياسة ، بحيث يتحول إلى برنامج كفاحي للمعذبين والمستغلين ، بغض النظر عن مذاهبهم وأديانهم .
إن برنامج العصور الوسطى يظل ملتصقاً ببرنامج شريعتي ، برنامج الشكل المذهبي للكفاح ، وبرنامج العجز عن تكوين طرح إسلامي عام وإنساني مشترك .
ويكمن في ذلك عدم القبول بضرورة التشكيلة الرأسمالية ، ولتجاوزها ، أو لتجاوز قوانينها وهي : الحداثة ، و الديمقراطية ، والعلمانية ، فهو يريد أن يقفز عليها . لهذا فهو يريد أن يقفز على هذا التطور فيؤجج : ( الروح الثورية والهدف المقدس والنزعة الشعبية المطالبة بالعدالة والمناهضة للاستعمار والرأسمالية برسالة التوحيد التي طالما ناهضت الشرك بمختلف أشكاله الفكرية منها . . لنصل إلى الغاية الكريمة المثلى وهي المساواة بين الناس في توزيع الثروة . . ولكي نثبت للجميع أن النظام الرأسمالي يجزئ الإنسان ويمسخه ويمثل به وان الدين الذي يدعو الإنسان إلى التكامل والتحلي بالقيم الأخلاقية المتعالية لا يمكن أن يبقى في هكذا نظام ) ، ( 10 ) .
يتضح هنا عدم القبول بالرأسمالية من مواقع الثورة والرفض للاستغلال ، وهو أمر إيجابي ، ولكن التشكيلة الرأسمالية ليست اختيارية بل إجبارية ، ولا يمكن أن تزول بوصايا أخلاقية ، بل عبر النضال داخل قوانينها الاقتصادية والاجتماعية ، ومن خلال نضال طبقاتها العاملة والمفكرة والمنتجة ، ولكن إذا لم تتشكل هذه القوى الاجتماعية وتمارس كفاحها وتخلق منظماتها وتجربتها وقيمها ، كيف يمكن أن يتشكل زوال الاستغلال ؟
بالنسبة لعلي شريعتي فإن الأفضل هو عدم دخول التشكيلة ، لكي يبقى الدين كمنظومة خارج التاريخ المعاصر ، أو بالأحرى ليبقى الإقطاع المذهبي مانعاً من تكون الطبقات وصراعها داخل الطائفة ، وليظل رجالُ الدين الطيبون سائدين فيها . هذه ليست خلاصة مقحمة بل هو التتويج لمجمل المنظومة الفكرية ، وهو أمر تشكل في تجربة إيران الأخيرة عبر هذا الوعي السابق عليها.
يقول علي شريعتي:
( الاستبداد هو من المعالم الطبيعية التي تتسم بها هكذا حكومة ، لأن رجل الدين سيشغل منصب خلافة الله وتنفيذ أوامره في الأرض . وفي هذه الحالة سوف لا يكون للناس حق إبداء الرأي والانتقاد والاعتراض ، فالزعيم الديني يعطي لنفسه حق الزعامة والقيادة مرتكزاً على قيمته واعتباره الديني لا على قيمة وآراء الناس وانتخابهم . إذن هو حاكم غير مسؤول وهذا النوع من الاستبداد هو أسوأ أنواع الاستبداد والدكتاتورية الفردية) ، ( 11 ) .
إن هذا رفض واضح للحكم الديني الشخصي المستبد ، وهو أمر يعبر عن فكر شريعتي المناهض للحكم الديني الفردي ، وليس لحكم المؤسسات الدينية أو الحكم الفردي المستند إلى هذه المؤسسات ، وهو الأمر الذي قامت به القوى الدينية في إيران عبر تضفير دكتاتوريتها بمؤسسات منتخبة مهيمن عليها .
ويطرح شريعتي الاستبداد هنا كحالة فردية وغير منتخبة من قبل الناس ، لكنه يقصد الحالة السياسية المعاصرة ، لأنه يؤمن بالإمام المعين ، كجزء من وعي الأثني عشرية ، ولهذا يستنكر ( مبدأ البيعة والشورى والنظام الديمقراطي في الحكم ) ، ( 12 ) .
وهذه التناقضات تعبر عن وعي الإقطاع المذهبي وهو يحاول الجمع بين الأنظمة المتضادة ، فمن جهة يحاول الإبقاء على هيمنته على الجمهور المؤمن ، وهذه لا بد لها من دكتاتورية ، ولكنه من جهة أخرى ، لا يناقض التحديث والرأسمالية بشكل مطلق ، بحيث أن لا تدمر سيطرته ، وهذه تحتاج إلى مؤسسات منتخبة من قبل هذا الجمهور المؤمن المطيع .
ولهذا فإن شريعتي يرفضُ الواقعَ التاريخي المعروف بوجود مؤسسات دينية متنفذة عبر التاريخ الإسلامي، ( أما الإسلام ، فلا يمكن إثارة هذا الأمر فيه لأن المجتمع الإسلامي لا يوجد فيه رجل دين بالمعنى الذي نراه في الأديان الأخرى.) ، ( 13 ) .
ونظراً لتعبير شريعتي عن وعي الإقطاع المذهبي الذي لم يتحدث بشكل كلي ، فهو لا يرى تناقضات الداخل المذهبي ، بل يرى الطائفة كتجسيد للحقيقة والعدالة ، كتماهٍ مع المطلق، وبالتالي تنتفي السيرورة الاجتماعية وقوانينها داخلها ، ومن هنا لا يرى تداخل رجال الدين والإقطاع ، ولا يرى تحولهم إلى شريحة من هذه البنية الاجتماعية ، وهي شريحة تؤبد نظام الاستغلال التقليدي ، وتعجز عن إعادة إنتاجه في شكله الرأسمالي الحديث المتطور ، على الأقل في زمننا هذا ، ولهذا تتطابق أحكامها الفقهية والسياسية معه ، وتتصور إن رؤيتها أبدية ، رغم إن شريعتي نفسه ، يرفض التقليد الفكري ، قابلاً التقليد الفقهي ، داعياً المؤمنين إلى التجدد الفكري والتنوع ، وهذا جانب تجديدي جزئي ، محكوم بدولة دينية .
إن وعي علي شريعتي يعبر عن وعي هذه الشرائح من الفئات الوسطى التي استفادت من الثقافة الديمقراطية المعاصرة ، لكنها ظلت تابعة فكرياً واجتماعياً للإقطاع ، خاصة إن نمو هذه الفئات هو بين القوتين الأساسيتين للإقطاع : القوة الحاكمة السياسية ، والقوة الموالية المعارضة الدينية . في حين إن الطبقة البرجوازية غير قادرة أن تكون طبقة مهيمنة بسبب غيابها عن الإنتاج الصناعي .
إن معارضة هذه الشرائح الوسطى للحكم المطلق يقودها إلى البحث عن قوى بديلة ، لا تجدها في فكر عصري قوي وفعال في مناخ إيران السابق ، ومع قيام الحكم المطلق بضرب كافة التجليات الحديثة للمعارضة ، وإنعاشه للمؤسسات الدينية ، تتوجه تلك الشرائح إلى التبعية الفكرية للإقطاع المذهبي .
إن فكرها في هذا الحصار الأمني والسياسي لا يمكن أن ينمو إلا مموهاً ، وحيث يمثل الوعي الديني مظلةً تاريخية عريقة ، مثلما تتشكلُ شرائحُ البرجوازية المعاصرة من أموال وصفقات الدولة ، أو من العقار والزراعة وسوق المؤمنين ، فتظهر الفئات الوسطى التابعة للدولة ، والفئات التابعة للإقطاع ، ومن هنا تتشكل جبهة تحرير إيران برأسين ديني وعصري ، ومثلما يضطرب خطاب شريعتي بين الدين التقليدي والحداثة ، لكن هؤلاء وقد فعلوا الإقطاع المذهبي يقوم بالتهامهم فيما بعد ، ليجعل الفئات البرجوازية تابعة ، لكن الصراع لم ينته ، وقد مثل خطاب شريعتي دفعة لنمو دولة الإقطاع المذهبي الشمولية دون أن يقرأ خطورة ذلك على مستقبل إيران .
الوعي بالتاريخ الإسلامي :
ينطلق علي شريعتي من موقف مذهبي وهو يصوغ رؤيته لتغيير إيران في زمن ممتد بين الخمسينيات والسبعينيات ، وهو الزمن الذي حدث فيه انبعاث الهياكل الاجتماعية والفكرية للإقطاع الديني ، وكما أوضحنا سابقاً ، أخذ يجوس بين موقفين في الفئات الوسطى الإيرانية خاصة ، والعربية الإسلامية عامة ، بين إنتاج مفاهيم للفئات نفسها ولم تكن لها سيرورة لتكون طبقة ، وبين التبعية للإقطاع .
وتكمن المواقف الأشد صعوبة لهذا المخاض في معالجة التاريخ الإسلامي ، حيث يتوجه شريعتي إلى توحيد و( بعث الأمة ) الإسلامية ، ولكن من داخل إيران وفي ظل وعيها المذهبي وتاريخه الخاص ، مما يجعله يصطدم بالتوجهات التقليدية داخل الطائفة ، وبعملية وعيها ، لهذا تغدو عملية التاريخ الإسلامي لإيران عملية صراعية فكرية وسياسية حادة .
وهذا ما جعل التقليديون المتطرفون يهاجمونه باعتباره ( سنياً ) ومشككاً في التاريخ الشيعي ، عبر موسوعته الإسلامية التاريخية ، لكنه يؤكد من جهة أخرى تمسكه بالثوابت المذهبية تجاه حكم الخلفاء الراشدين الثلاثة الأول ، باعتبارهم مغتصبين لحق الإمامة من علي بن أبي طالب ، لكنه يعترف لهؤلاء بموضوعية الحكم ونزاهته .
إذن فإن علي شريعتي يقوم بالتنظير من داخل فضاء المذهب الأثني عشري ، من أجل النهضة والتجديد وتوحيد ( الأمة ) ، ولهذا فهو يطرح تاريخاً خاصاً لهذه الأمة .
من أجل هذا يقوم بالمقابلة المتضادة الحادة بين ( السنة ) و ( الشيعة ) ، حيث يحول هؤلاء وأولئك إلى ثوابت وجواهر خارجة عن خريطة التاريخ الموضوعية ، رغم إنه يضعهما في بعض ظواهر هذا التاريخ ، وفي كتابه ( التشيع العلوي والتشيع الصفـوي ) يهاجم من يرفض التعاون مع الدولة العثمانية لمواجهة الغرب ، معتبراً توحد المسلمين ، رغم الاختلافات ، ضرورة هامة لإعادة تشكل الأمة ، ولكنه يرى المذهبين الرئيسين بالصورة التالية :
( وإلى جانب ذلك تحول المذهب السني الذي مثل على الدوام دين الدولة( الرسمي ) إلى مجموعة شعائر طائفية(….) تبرر الممارسات اللاإنسانية للجهاز الحاكم ، وتتبرع بأحكام وفتاوى جاهزة تناغم التوجه الرسمي للحكومات المتعاقبة وسلاطين الغزنوية والسلجوقية والمغولية ، وأضحى الدين بمثابة أفيون للشعب وآلة قمع وتنكيل بكل حركة إصلاحية تهدد مصالح الأقوياء وأصحاب رؤوس الأموال) ، ( 14 ) .
ورغم أن علياً يقصد هنا الاستخدام المحدد للمذهب السني في مثل هذه الدول الاستغلالية ، إلا أنه يعمم ذلك على التاريخ الإسلامي بمجمله ، فيغدو الأمر مذهباً سنياً واحداً وحاضراً منذ أيام الخلفاء الراشدين ، مثلما يقول عن علماء الزور في التاريخ الإسلامي عامة ( الذين يستغلون عنوان المذهب السني لتمرير مخططاتهم الرامية بالأساس إلى فرض الهيمنة على مقدرات الشعوب وتبرير أعمال السلاطين) ، ( 15 ) .
يظهر التاريخُ الإسلامي في بدء انقسامه في وعي علي شريعتي ، حين حدثت مؤامرة مبيتة ضد الإمام علي بن أبي طالب ، لأبعاده عن الحكم ، وإنكار حقه الشرعي في الخلافة ، ومن هنا بدأ ظهور المذهب السني .
وفي الحقيقة إنه كان ثمة صراع اجتماعي وسياسي ، بين مجموعات الصحابة المختلفة ، يعكس رؤى فكرية سياسية متعددة ، فمحور أبي بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص وغيرهم كان يمثل استمراراً لمحور التجار المتوسطين المتعاونين مع الفقراء لتشكيل دولة لا يحكمها الأشراف المتسلطون ، ولهذا ركز هذا المحور على إبعاد الهاشميين عن تسلم السلطة ، فذلك يؤدي إلى احتكارهم أمرين عظيمين هما النبوة والدولة ، كما ركز على إبعاد الأمويين كذلك عن تسلم السلطة .
الذي كان يوحد محور أبي بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص هو كونهم كذلك من المشجعين لصعود الأفخاذ القبلية غير الكبرى في قريش ، فالأفخاذ الكبيرة حين ستستلم السلطة لن يكون بمقدور العرب إزاحتها ، وهذا المحذور والحدس قد تحقق فعلاً .
أي كان هذا المحور وراء الأفكار الجنينية للجمهورية الإسلامية ، أما أن ذلك كان مؤامرة مدبرة موجهة لطائفة ، ولأجل طائفة أخرى ، فهو وعي زائف وغير تاريخي ، بسبب إن قضايا الطوائف لم تكن تخطر ببال حينذاك . إن الطوائف هي تشكيلات في الوعي والوجود الاجتماعي متأخرة كثيراً عن هذه الحقبة ، أي إن الطوائف لم تتشكل في هذا العصر ، وهي تعود لعصر آخر ، ولكن هذا الوعي الطائفي المتشكل بشكل متأخر ، هو الذي أقتحم تلك الفـترة الأولى ، ودمغها بقراءته .
لقد كان الإمام علي بن أبي طالب يمثل محوراً آخر في الصحابة حينذاك ، هو محور الفقراء ، الذين كانوا هم قوة الإسلام الأولى ، والتي تحملت التضحيات ، لكن القوى الاجتماعية الأخرى أخذت تصعد ، وتتنامى ثرواتها وتقترب من السلطة ، كذلك فإن الصحابة الفقراء تبدلت أحوالهم ، ولم يعد هذا المحور قادراً على طرح برنامج سياسي واجتماعي معين في سنوات الخلفاء الراشدين الأولى نظراً لتطابقه مع سياستها ، أما الفئة الوسطى التي كانت هي العمود الفقري لتماسك الحركة الإسلامية وقتذاك فقد تخلخلت مستوياتها وصعد بعضها إلى القمة .
إن الحديث عن مؤامرة أو خطة لإبعاد الإمام علي عن السلطة بسبب شخصه ، هو أمر غير محتمل ، لأن الخوف من الحكم الوراثي هو ما كان يقلق الصحابة المؤثرون على مقاليد الحركة الإسلامية في وضعها المبكر ذاك .
وفي مقطع آخر فإن الباحث النزيه في شخص علي شريعتي نفسه هو الذي يطرح الدليل على هذا الواقع السياسي الذي يخلو من نظرية المؤامرة المريضة ، فيقول :
( لقد لزم علي جانب الصمت حرصاً على وحدة المسلمين حيال الخطر الخارجي الذي يهدد الجميع من إمبريالية الشرق والغرب في العالم القديم ، ومؤسسو التشيع العلوي فعلوا الشيء نفسه طاعة لإمامهم ، أما أبو سفيان فإنه أبى السكوت مطلقاً ، فالرجل غير مستعد للتخلي عن ولاية علي ) ، وأضاف أبو سفيان ( مال بال هذا الأمر في أقل حي من قريش؟) ، ( ثم قال لعلي أبسط يدك أبايعك!) ، ( فزجره علي وقال: والله ما أردت بهذا إلا الفتنة! ) ( 16 ) .
هنا نرى الإمام علياً وهو غاضب لإبعاده عن السلطة ، وهذا من حقه ، ولكنه في ذات الوقت ينتظر ماذا سيفعل الخليفة الأول وجماعته في الدولة ، ويأتي أبو سفيان إليه لتفجير الموقف السياسي وليشخص طابع المرحلة تماماً وهو إبعاد الأفخاذ الرئيسية من قريش عن مركز القرار ، سواء كانت من بني هاشم أم بني أمية ، وليتمكن النظام الوسطي الجمهوري ، من النمو بين هاتين القوتين المتعاديتين الكبيرتين ، وقد قام أبو سفيان الداهية بمحاولة نسف وجود الدولة الإسلامية الجنينية ، وبمواصفاتها الشعبية تلك ، ولتفجيرها من الداخل ، ولكن لو كان الأمام علي هدفه السلطة الشخصية المحضة لسارع إلى قبول ذلك ، ولكنه يؤيد الموقف الصحيح بغض النظر عن من يحكم ومن يمثله ، فيطرد أبا سفيان !
إن موقف أبي بكر وعمر إذن في ذلك المخاض كان متجهاً لتشكيل سلطة منتخبة وشعبية ، بمعنى إنها غير نابعة من احتكار الأشراف ، ولأن ذلك كان مضاداً لطبيعة العرب الاجتماعية وقتذاك ، وبهذا فقد نجحا في تكوين دولة ذات مواصفات غير أرستقراطية وغير متعالية ، وكانت عملية الفتوح الواسعة التي تأثر فيها الشعب الإيراني وانهارت إمبراطوريته ، هو أحد الجراح والأسباب التاريخية لكراهية تلك الفـترة من العهد الراشدي ، أو العقدة النفسية التاريخية لعدم الوصول إلى تقييم موضوعي عنها من قبل الوعي الإيراني ، وتحميل الشخوص والرموز التاريخية ما لا تتحمل ، أو ما لم تفعله .
إن هذه الفترة كانت تهجسُ بنمطين من نظرية السلطة لدى المسلمين ، وذلك ما كان يهجس به عمر على وجه خاص ، فما طرحه كان الشورى والانتخاب ، ورفض حكم الوراثة . ولكن النمط الثاني هو الذي انتصر ، نمط احتكار السلطة والثروة بالوراثة ، وتحويل الجمهور إلى خدم للعوائل المالكة . والنمط الأول لم يجاهد المسلمون كثيراً لتجذيره في تاريخهم .
لا نعرف الخريطة الاجتماعية العميقة لتطور إيران عبر وعي شريعتي ، فهي تبدو سجلاً لحركات سياسية واجتماعية مستمرة دون أن يتشكل لها تاريخ خاص، وشخصية تاريخية ، فهو يطبق عليها نظرية اجتماعية أوربية عن ظهور حركات تنمو بسبب عدم تحقق أهدافها وهي تخبو بتحقق هذه الأهداف،( 17).
والغريب إن إيران هي المعمل الكبير للحركات الثورية عبر التاريخ ، ولم يشهد شعب آخر مثل هذا التطور المثير ، ففي البدء ظهرت الزرادشتية، حين أصبح رجال الدين متداخلون مع الأسرة الحاكمة ومالكو القسم الأكبر من الأراضي الزراعية ، وحينئذٍ فقدت الزرادشتية دورها باتحادها مع الطبقة الحاكمة ، وبدأت حركات أخرى، كالمانوية والمزدكية ، ويقوم شريعتي هنا بقطع الوعي عن الصراع الاجتماعي ، فظهور حركات أخرى تمثل الفئات الوسطى عبر المانوية والفلاحين عبر المزدكية ، هو أمر يمثل جزءً من الصراع الاجتماعي الفكري المتداخل ، وليس شيئاً مجرداً ، كما أن استمرار هاتين الحركتين الأخيرتين في العصر الإسلامي يعبر عن مقاومة القسم الأكبر من الشعب الإيراني للفتح العربي ، وخاصة مع وقوع الملكية العامة في يد عائلات الأشراف . ويستمر شريعتي في عدم دراسة هذه اللوحة المعقدة للتاريخ الإيراني ، فدخول الإيرانيين للإسلام كان يتشكل عبر معارضتهم للاستغلال والحكم المركزي ، أي عبر استثمار تاريخهم الكفاحي السابق العريق ، ولهذا وجدناهم يتبنون وجهات نظر المعارضات الإسلامية المختلفة ، ولم يقفزوا فجأة إلى تبني المذهب الأثني عشري في القرن السادس عشر الميلادي فجأة ودفعة واحدة ، فقد وقفوا مع الهاشميين بمختلف فرقهم ، بل لقد أيد قسم من الشعب الإيراني الخوارج على إعرابيتهم الشديدة ، ثم استطاع الزيديون أن ينتشروا في إيران بسبب كفاحهم ضد الحكم العباسي المستغل ، ولكن الزيديين كانوا دعاة ثورة مستمرة ، لا يقبلون بالقعدة ، مما أدى إلى استنزاف قدراتهم . ثم انتشر التيار الإسماعيلي في إيران لعدة قرون وكان فكرهم يتسم بالتعددية والموسوعية وهو نتاج التطورات الثقافية الكبيرة عند المسلمين ، ولكن كفاحهم كان يتسم بالإرهاب والتآمر ولم يستطيعوا أن يحرروا إيران من السيطرة الخارجية التي تمظهرت في القبائل السنية وأرستقراطيتها .
وهكذا فإن الأثني عشرية لم تظهر فجأة في التاريخ الإيراني مع الدولة الصفوية ، بل كانت نتاج التطورات الفكرية السابقة ، وبسبب عجز التيارات المذهبية المعارضة عن إنتاج نظام استقلالي وقومي إيراني ، ولجمع الأثني عشرية بين المعارضة والسرية ، ولنموها التدريجي ثم دورها في تحرير إيران من المغول .
ومن المؤكد إن العناصر الفكرية المعادية للعرب كانت مضمرة وبقوة في الوعي الشعبي الإيراني ، وكان الاستقلال عن العرب يلعب دوراً كبيراً في التاريخ الإيراني ، بسبب قيام العرب بهدم الإمبراطورية الساسانية ، ثم بسبب نتائج الغزو والاستغلال الطويل وكل هذه تركت جراحها في اللاوعي العام ، وحين قامت الدولة الصفوية اعتمدت على سياسة مهاجمة العرب وإزالة المذاهب السنية كرد فعل على الاضطهاد الطويل وكمحاولة لتكريس نفسها كمدافعة عن المذهب الجعفري ، وعلي شريعتي يقف هنا ضد هذه العمليات التعصبية من الطرفين المذهبيين ويكرس كتابه عن التشيع العلوي في الهجوم على التشيع الصفوي ودوره في إنتاج عقلية دينية شيعية شكلية وفي التفريق بين المسلمين .
نستطيع أن نلخص ذلك كله بالقول إن الوعي الإيراني وهو في استقباله للإسلام كان يبحث عن وجهات النظر المعارضة بشتى ألوانها ، وعلى مدى قربها من قضاياه ، ونظراً لثوريته فإنه يوصل هذه المعارضة المعبرة عن طابع العصر إلى أقصى حالاتها، ومن هنا نرى تتابعها : الخوارجية ، القدرية ، الاعتزال ، الهاشمية ، الزيدية ، الإسماعيلية ، العلوية . وكان لا بد له أن يختلف مع هؤلاء الذين هدموا إمبراطوريته واستغلوا بلده ، وأن يظهر ذلك في الهجوم على رموز الفتح العربي بدرجة أولى . فالأساس الذي حكم تطور الوعي الإيراني الإسلامي هو مدى تعبير تلك الموجات الإسلامية عن مطالب الشعب والعاملين ، وليس هو التطور المجرد في ذاته.
فحتى الأثني عشرية في تعبيرها عن الجمهور المستغل الإيراني لم تحسم خيارها الاجتماعي بين الفلاحين والإقطاعيين ، بل إن الإقطاعيين هم الذين سيطروا على إنتاجها ، وتمظهر ذلك في سيادة الدولة الصفوية بشاهاتها وأمرائها ورجال دينها، وفي ذلك يقول شريعتي نفسه :
( التشيع الذي كان (ضد الوضع القائم) أصبح الآن (مع الوضع القائم)، التشيع الذي كان قوة مناوئة لأجهزة الحكم، تحول الآن إلى قوة دعم وإسناد لهذه الأجهزة وبالتالي تبدل الدور الذي يلعبه فالتشيع كان يمارس دوراً نقدياً لسلوك الحكام أصبح يمارس الآن دوراً تبريراً لسلوكيات الحكام وتصرفاتهم !) ، ( 18) .
حين يتصور علي شريعتي إن ديناً من الأديان يستطيع أن يعبر بشكل جوهري عن المظلومين وعن تحقيق قضايا العدالة ، بشكل مطلق ، فإن ذلك يتشكل خارج التاريخ ، وإن كان يتلامس مع بعض مواده ، لأن الأديان تعبر عن أنظمة، وعن مجمل الطبقات ، فهي رغم ظهورها كأشكال كفاحية للمضطهدين ، إلا أنها تحولت إلى أنظمة دول ، فيغدو من المستحيل أن تعبر عن طبقات دون طبقات أخرى ، إلا عبر المذاهب التي تستحيل هي بدورها تعبير عن مجمل الطبقات وعن كيانات سياسية جديدة ، وبهذا فإن الدول تتفسخ وتنهار ، وهذه العملية وجدناها في تعبير القوى السياسية والاجتماعية عبر الوعي الديني ، فظهرت المذاهب وانهارت الإمبراطورية الإسلامية .
ولهذا فإن تصور شريعتي بإنه يمكن لمذهب أو دين أن يعبر عن المضطهدين ، وعن الطبقات الشعبية دون الطبقات المالكة ، هو أمر غير ممكن ، لأنه سيكون دائماً تعبيراً عن جميع المنتمين إلى هذا الدين ، وبهذا فإن على الصراع الاجتماعي والسياسي أن يبحث عن أدوات أخرى ، غير الدين .
لقد كان ظهور الإسلام عند العرب بدا وكأنه تعبير عن العرب فقط ، أو كأنه الشكل الديني لبروزهم القومي ، خاصة مع اعتماده على لغتهم وإرثهم الاجتماعي ، ولكنه مع ذلك صار ديناً عالمياً ، وقد ظلت العروبة في قلبه الفكري والتاريخي ، وكذلك صار ديناً إيرانياً ، وتركياً ، الخ . . فعبر عن تجربة هذه الشعوب وهي تنتقل من العصر القديم إلى الوسيط .
فلم يعد ديناً للفقراء أو الأغنياء أو العرب أو الإيرانيين أو الأمازيغ ، بل لهؤلاء جميعاً ، فلم تعبر به القومية السائدة فحسب ، بل المسودة أيضاً ، ولا الطبقة المسيطرة بل المسيطر عليها كذلك ، وبهذا خرج من التعبير عن فئة أو طبقة أو أمة واحدة .
نستطيع أن نقول عن ذلك إنه شكل عالمي ، مس كافة الشعوب ، ولكنه شكل كما عبر شريعتي نفسه ، في مواقع أخرى من خطابه ، تستطيع أن تتوغل فيه كافة الطبقات والرؤى ، وخاصة قوى التحكم والتسلط ، وتفرغه من مضامينه الأولى ، وقد حدث هذا في التشيع كذلك هذا الذي كان تعبيراً عن المعذبين والمظلومين كما يقول شريعتي، ( إذن للتشيع حقبتان ، بينهما تمام الاختلاف ، تبدأ الأولى من القرن الأول الهجري ، (…) وتمتد هذه الحقبة إلى أوائل العهد الصفوي ، حيث تبدأ الحقبة الثانية والتي تحول فيها المذهب الشيعي من تشيع حركة إلى تشيع حكومة ونظام .) ، ( 19 ) ، وهو أمر يثبت إن كل دين وكل مذهب يتمكن الأغنياء والمتسلطون من تبديل مضامينه ودلالاته ، ولكن شريعتي لا يستنتج استنتاجات علمانية من هذا التاريخ الديني المؤدلج ، بل يصر على استمرار استخدام الدين في الصراع السياسي ، وقد عبر هو بذاته عن هذا التغلغل والتحكم حتى في تاريخه المذهبي . فهاهو التشيع الصفوي يتحكم عدة قرون في إيران موجهاً تاريخها الفكري والسياسي نحو الصدام مع المسلمين الآخرين ، يقول :
( المهم والمشكل إن المذهبين لهما نفس الأصول ونفس الفروع، ذلك إن التشيع الصفوي جاء وأرسى دعائمه على هيكلية مضاهية لهيكلية التشيع العلوي، واستعار نفس القوالب الفكرية والعقائدية لهذا التشيع بعد أن أفرغها من مضمونها ومحتواها ) ، ( 20 ) .
وهكذا تقوم كلُ سلطةٍ بهذه العملية التفريغية للأفكار الثورية والدينية ، فلا يكون الحل إلا بالديمقراطية والعلمانية وهي القسمات التي نبعت من محاولة تجاوز مشكلات الدولة الدينية والدولة (الإيديولوجية) الشاملة ، ولكن شريعتي يصر على استمرار محاولة تنظيف الدولة الصفوية ومذهبها وإعادة إنتاج دولة شيعية من نمط مختلف .
يحاول شريعتي في كتابه ( التشيع العلوي والتشيع الصفوي ) أن ينظف الفكرة الشيعية النقية من التلوث الإقطاعي الصفوي ، حين استطاع الصفويون جعل المذهب الإثناء عشري هو مظلة الدولة الفكرية الإيرانية ، فمن جديد استطاع الحكام والمستغلون من تحويل المذهب الثوري إلى مذهب محافظ ، ولهذا يقوم شريعتي بنقد الممارسات الشكلية لهذا المذهب التي جعلتها الدولة الصفوية الشكل الوحيد لتجليه ، مبعدة معاناة الأئمة وكفاحهم من أجل الناس، من أجل أن يعود التشيع العلوي الحقيقي ، وأن تتم إزالة الاستغلال عن الشعب باعتبارها القضية الأولى في الدولة والمذهب ، موجهاً نقداً مريراً للممارسات العبادية .
إن شريعتي يحمل كل أحلام المناضلين عبر القرون لإزالة الظلم واللامساواة موقناً بأن مثل هذه الأحلام ممكن أن تتحقق فقط عبر المذهب العلوي ، لأنه كرس في كل تاريخه هذه المعاناة ، ولكن هو بذاته ينقد ثلاثة قرون من هيمنة الصفويين على المذهب وتحويله لمصلحة المسيطرين على الدولة والإقطاعيين السياسيين والدينيين ، نظراً ليس لنمط العبادات التي يعبر فيها المؤمنون عن معاناتهم ووحدتهم ، بل لغياب التمثيل الديمقراطي للطبقات المختلفة داخل المذهب والدولة .
فحين يعبر دين أو مذهب عن مجمل الطبقات ، فهذا لا يعني سوى سيطرة الأقوياء والأغنياء من داخلهما على توجيه الدين أو المذهب واحتكار معانيهما وغلاتهما الاقتصادية . في حين إن الطبقات الفقيرة تكون هي المستغلة والمضطهدة والمبعدة عن السلطة ، وهذا ما كان يؤدي إلى تفكك الأديان والمذاهب .
إذن تغدو الديمقراطية والعلمانية هي السبيل لحماية الأديان والمذاهب من المتاجرة بهما ، وفيهما تستطيع الطبقات المختلفة أن تدافع عن مصالحها المتنوعة ، وبطبيعة الحال فإن الطبقات المسيطرة الاستغلالية التقليدية لا تريد أن يتشكل مثل هذا النظام السياسي ، كما أن الطبقات الفقيرة لا تعي ذلك مؤقتاً ، ولكن الصراع الاجتماعي وتباين المصالح يدفعها لإدراك ذلك والنضال من أجله .
كما أن ذلك هو الذي يوحد الطبقات العاملة و المالكة في كياناتها الموضوعية ، ويوحد الوطن والأقطار الإسلامية في نضالها المشترك .
إن رفض الدينيين الحاليين الاعتراف بتنوع المصالح ، وبالتالي بالديمقراطية ، داخل الطوائف والأديان ، يتماثل والأنظمة الدكتاتورية الدينية والسياسية الراهنة ، الت
January 25, 2024
موقع جديد لقصص عبـــــــدالله خلــــــــيفة
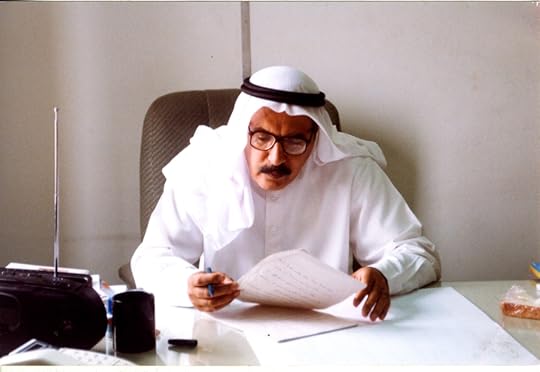 عبـــــــدالله خلــــــــيفة
عبـــــــدالله خلــــــــيفة انقر على الرابط ليصلك الموقع الجديد
January 19, 2024
عبدالله خليفة .. كي لا يُدفن مرتين !
كتب : أحمد البوسطة
في الحادي والعشرين من أكتوبر 2014 خسرت الساحة الثقافية والأدبية والسياسية والصحافية، البحرين ومنطقة الخليج عموماً واحداً من أبرز روائييها ، كتابها الصحافيين ، باحثيها الجادين ، مثقفيها النقيين ومبدعيها الذين انحازوا لنصرة المعذبيين على البحر واليابسة ، ودفع ضريبة مواقفه وعشقه للحرية والتنوير والانتماء الوطني ، هذا الانسان اسمه عبدالله علي خليفة البوفلاسة.
عاش حراً ومات حراً .. مات ولم يملك شيئاً غير مؤلفاته الغزيرة ، ولكنه عاش ولم يتملكه أحد أو يجيره ، ألف أكثر من 60 مؤلفاً بين رواية ودراسة وبحثاً نقدياً في الأدب , كانت له كتابة يومية للرأي في “الافق ” وتحقيقات صحافية ميدانية وكان مسؤولاً عن تحرير الصفحات الثقافية .. بعد وفاته لا زالت تحت الطبع ثمان روايات جديدة لم تطبع بعد من بينها رواية “رسائل جمال عبدالناصر السرية” ورواية “ابن السيد” وخليج الأرواح الضائعة” بالإضافة إلي الجزء الرابع من سفره الفكري الكبير : “الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية” تحت عنوان ” تطور الفكر العربي الحديث” وكلها تنتظر الولادة .
حتى آخر يوم في حياته كان يقرأ بنهم ويكتب بغزارة , فكانت آخر قراءاته رواية “وجهان لحواء” وجدها شقيقه عيسى بالقرب من وسادته وبين اورقها رشوتات المستشفى وعشرة دنانير , هذه الرواية الأخيرة التي قرأها من تأليف “أمريتا بريتام” واحدة من ضمن سلسلة “إبداعات عالمية” للعدد رقم 326 من هذه الإصدارات التي ينشرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدب الكويتي . آخر ما خط به قلمه في دفتر مذكراته كلمات توديعية مؤثرة قال فيها : تأتي الريح وتقذفه بعيداً بين أشجار العصافير وأجنحة النسور .. يمضي مع ورق الشجر المتطاير من الصخور وثلل بشرية خريفية تتساقط في المدن.. يشق طريقه تترامي قراطيس كثيفة له في الأزقة .
في البناية الرثة (…) كلمة غير واضحة . ربما قصد بها “أشاهد” الحمامات , تعيش في الشقوق وتتزاوج ( يتحث عن الشقة العتيقة التي سكنها طيلة 21 عاماً و المبنى المقابل لشقته حيث كانت الشقوق محاكر للحمام)
يخبرنا في أخر كتاباته : ” أخوه يحيط به مثل الشجرة . من أصابعه يظهر الحليب والبيض وأصوات المعادن .(الاواني)
الآله تطلقه في الفضاء .. ومليون دواء ، الشارع مغلق.”
( يتحدث عن شقيقه عيسى الذي كان جليسه الوحيد في الشقة العتيقة حتى آخر أيامه ويقوم بخدمته).
كتب الروائي اليساري الراحل عبدالله خليفة هذه الكلمات الأخيرة بخط يده وهو يحتضر قبل يوم أو يومين من رحيله على ما يبدو ، واضح من ارتجاف قلمه في يده وتباعد الحروف ، لكنه أبي إلا ان يكتب آخر الحروف بوداع حزين يختزل شذرات حياته بالعطاء الأدبي والفكري والنضالي التاريخي الدائم بعد ان أضناه مرض العضال الذي نتشر في جسده ولكنه لم يستسلم له حتى آخر دقيقة من عمره .
هذا الإنسان الرائع والمبدع والنقي الإيديولوجي . بالمناسبة كان عبدالله حين يمتدح شخصاً من رفاقة ومحبيه بم يكن بين الحضور لا يقول “هذا الرجل” بل “هذا الإنسان ” بما فيها من دلالة لا شوفينية ولا قومية ولا أو عقائدية ، كان يكتب القصة القصيرة والرواية منذ أواخر الستينات حتى غدت مؤلفاته في النقد الأدبي والرواية وقضايا الفكر أبرز كتاب الخليج
قاطبة غؤارة ومضمونا ، لكنه وللأسف لم ينل التكريم اللائق من دولته ، ومن يقرأ روايته : ”ذهب مع النفط” ويتمعن في سطورها وتحطيم المثقف يعرف السبب ، ومن يقرأ رواية : ”أغنية الماء والنار” وراية “امرأة” و”الينابيع” ملحمة الملاحم و”لحن الشتاء” إلي أخره…
فقدنا عبدالله الذي كان شعلة نضال وبرفقته تعرف إنه صفحة للبياض الأول وإنساناً يجاهد الوقت والنسيان ، فلا تنسوه مثلي!… لك الخلد أيها الرفيق الصديق النقي الطاهر .
أن تكتب الأدب في السجن: أحمد البوسطة
عند التفكير بالكتابة عن أدب السجون في البحرين، لا يستطيع أحد تجاوز الروائي والمناضل الراحل عبدالله خليفة وآخرين من شعراء وأدباء وأيضاً نحاتون وضعوا بصماتهم على صخور معتقل جزيرة جدا آنذاك .. ما هي ابتكاراتهم لتحقيق هذا المنجز الإبداعي أو ذاك، وكيف يواجهون الأخطار للحفاظ وتأمين ما أنجزوه حتى يخرج من الظلمات إلى النور… من السجن إلى خارجة بعيداً عن أعيّن الشرطة؟
عبدالله خليفة واحد من هؤلاء، كيف كان يكتب قصصه ورواياته ودراساته النقدية في الأدب والفكر خلف القضبان؟..
على أية ورق يكتب، في حين يمنعه السجان التزوّد بالورق وحتى بدفتر مذكرات، وبأي قلم يكتب والأقلام ممنوعة على المعتقلين وسجناء الرأي والضمير حتى لو كان قلم رصاص طوله أصبع لكتابة خواطره فترة التغييب القسري؟.. كيف كانت تُهرّب هذه الكتابات من داخل السجن إلى خارجه لتطبع على ورق مصقول وتتلاقفها الأيدي سراً خلسة عن الرقيب؟.
من الروايات والقصص التي تمّ تهريبها من السجن إلى خارجه طيلة فترة اعتقال عبدالله خليفة الذي استمرَّ ست سنوات منذ الهجمة على الوطنيين بعد حل المجلس الوطني في العام 1975 حتى أفرج عنه في العام 1981 والتي كُتِبَتْ على رقائق غلاف عُلب السجائر: روايات «اللآلئ» و«القرصان والمدينة» و «الدرويش والذئاب»، وهذه الأخيرة لم تنشر بعد، إضافة إلى قصص قصيرة حوتها فيما بعد مجموعة «الرمل والياسمين».
يروي أحد رفاقه الذين عايشوه حرارة الأوضاع في السجن، كيف كانت المعاناة لتوفير قلم وأوراق، كنا لا نرمي الأكياس ولا عُلب السجائر وننقل قلم «البنسل» – قلم الرصاص، والاسم الحركي المتعارف عليه بيننا: «حمبوص» من زنزانة لأخرى عبر مخابئ في حمامات السجن الذي نقضي فيه حاجاتنا، نلتقط الإشارات البعيدة عن أعين الرقيب والشرطة. وأحيانا بمساعدة شرطة متعاونين ومتعاطفين مع مظلوميتنا لتأمين الورق والأقلام للمبدعين ومن بينهم الراحل الرفيق عبدالله خليفة الذي كان غزير الإنتاج الإبداعي، نهم في القراءة، له عالمه الخاص، كتُوم، قليل الكلام كثير العمل والاجتهاد ويطلق النكات أحياناً، يلتقط العابر ليوظفه في رواية أو قصة.
ما أن يتم توفير بعض الأوراق وجمعها من زنزانة وأخرى حتى يقضي عبدالله عليها، وفي اليوم التالي يطلب المزيد وقلم رصاص آخر حتى أطلق عليه لقب أكبر مستهلك في السجن للورق والأقلام، وأي ورق وأي أقلام، الآن فهمنا، كيف استطاع هذا المبدع والمفكر أن ينتج أكثر من خمسين مؤلفاً، بين رواية وقصة قصيرة وكتب نقدية في الأدب وأربعة أجزاء من كتابه الضخم: «الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية» وخلال عام من مرضه العضال لم يتوقف عن الكتابة ولديه 15 رواية لم تطبع بعد إضافة إلى 13 رواية لم ينته من كتابة كامل فصولها و بأحجام مختلفة.
أثناء المقابلات في السجن مع عبدالله خليفة يتقصد شقيقة عيسى بوضع قلم في جيبه الأمامي بشكل لافت ويتربص فرصة مغافلة الرقيب لتهريبه له.
في إحدى المقابلات جلس عيسى في مقابله وجهاً لوجه، بينما والده وشقيقته جلسا على جانبيه، الأيسر والأيمن، كانت عيناه وهو يتحدث إلينا تمعن بحركات تمويهية على القلم وأكاد أرى لعابه يسيل مثل جائع يرى أمامه وجبة دسمة يريد التهامها، يقول عيسى، في ذلك اللقاء حدث شيئاً طريفاً، حيث كان يراقبنا الضابط راشد عبدالرحمن، خرج ثوانٍ لظرف ما لا نعرفه، أغلق الباب وراءه، فقام عبدالله بفتح جورابه ومدَّ رجله أمامي. في إشارة لوضع القلم في فتحة الجوراب، تداركت ببديهية لما كان يريد، فوضعت القلم وكان له ما أراد، أسند ظهره إلى الكرسي وعاد للحديث معنا بارتياح شديد وكأن شيئاً لم يكن.
شقيقه عيسى، لا يزال يتذكر.. كان قلم حبر جاف، ماركة «باركر» من أجود أنواع الماركات آنذاك، وكان ذلك في النصف الثاني من سبعينات القرن الماضي.
كان عبدالله يكتب نصوصه الأدبية ورسائله التي تصلنا بقلم الرصاص، وفيما بعد يستخدم قلم الحبر الجاف، وأدركت من خلال نصوصه الأدبية الجديدة أن عملية تهريب «الباركر» في جورابه بالرجل اليسرى قد نجحت، فها هو يخط بذاك القلم الذي وضعته بيدي في جورابه.. اجتاحتني فرحة كبيرة وتمنيت أن يسقط مطراً لأمشي تحته كي يُبللني.
«تفخيخ» برواية «اللآلئ»
علم رفاق (ع ج س) قرب الإفراج عنه خلال أيام ففكروا كيف يهربون معه رواية «اللآلئ» لعبدالله خليفة ونصوص للصحافي إبراهيم بشمي، قال له أحدهم في يوم الإفراج سنهدي لك بنطلوناً من بنطلوناتنا ذات الجودة بدل بنطلونك «الكحيان» هذا، لتقابل أهلك بهندام نظيف، تبادل معهم الابتسامات البريئة دون علمه بخططهم في تهريب «أوراق ممنوعة» من داخل السجن إلى خارجه.
قبل أيام من مقابلة إدارة السجن للإفراج عنه كانوا يخيطون الأوراق الصغيرة في البنطلون الهديّة، رزم من الأوراق، كل فصل من فصول الرواية بجانبه فصل آخر يخاط بإتقان يُبعد الشبهات.
تزامن موعد الإفراج عن (ع – ج) مع الانتهاء من «تفخيخ» بنطاله بالنصوص الأدبية، أعطوه رسائل شفوية للقاء شخص ما بالبنطال ذاته كشفرة متفق عليها، وعند وصوله المنزل اكتشف تلغيم بنطاله برواية «اللآلئ» لعبدالله خليفة ونصوص بشمي.. فسلم الأمانة إلى أصحابها وكان يضحك على نفسه لعلمه متأخراً عن هدية الإفراج من رفاقه الذين غادرهم إلى فضاء الحرية وهم لازالوا خلف القضبان.



