عبـــــــدالله خلــــــــيفة's Blog: https://isaalbuflasablog.wordpress.com , page 22
January 18, 2024
القليل من موسيقى محمد عبدالوهاب 2 من 2
January 16, 2024
القليل من موسيقى محمد عبدالوهاب 1 من 2
القليل من موسيقى محمد عبدالوهاب
مانديلا وشروطُ التقدمِ الموضوعية: كتب ــ عبدالله خليفة

تعتمد الزعامةُ الديمقراطية المتطورة على تطور الشعب وميزاته، فهي نتاجُ الخصائص الذاتية للفرد ومستوى تطور شعبه معاً.
وليست هذه الصلابة والأفق السياسي المفتوح والتضحية سوى خصائص تشكلت في مجتمع متطور مختلف عن الكثير من البلدان الإفريقية.
وضع المهاجرون الهولنديون الذين يُطلق عليهم محلياً اسم (البوير) الأساسَ الصناعي الحضاري لتقدم هذا الجزء الجنوبي من إفريقيا، الذي اختاروه لطبيعته المعتدلة ولبعده عن العمق الإفريقي ولكنوزه وإطلاله على المحيطين الهندي والأطلسي.
احتاج المهاجرون الأوربيون إلى عقود طويلة لكي يتلاءموا ويغيروا هذه الطبيعة الخام لإفريقيا حيث الثروة الزراعية والحيوانية تحتاج إلى جهود طويلة من أجل تطورها، وقد تداخل المستعمرون الهولنديون والإنكليز في عملية السيطرة على هذا الجزء ودارت بينهم حربان، وأَخضعتْ إنجلترا هذه المستعمرة الأوروبية الإفريقية المتداخلة المشاكسة، وحين سيطر عليها البوير تماماً كرسوا نظاماً عنصرياً في منتصف القرن العشرين، مما دلَّ على جذورهم العنصرية الفكرية السياسية، التي أرادت إقامة حواجز غير ممكنة بينهم وبين الشعوب السوداء.
لقد تقدمت القبائلُ الإفريقية تدريجياً في جسم البوير السياسي الجغرافي، مقدمةً قوةَ العمل الرئيسية في المهن الصعبة الرثة في البدايات النهضوية، وحين تحول البوير إلى الطبقة الصناعية المالية الحاكمة في غالبية فروعها فإن قوى السكان الإفريقية تحولت إلى الطبقة العاملة الصناعية التي تشتغل في المصانع ومناجم الذهب والماس.
لقد تحولت جنوب إفريقيا إلى أكثر البلدان تقدماً في إفريقيا وغدت أكبر منتج للذهب والماس وغدت أكبر قوة مصنِّعة للسيارات والسلع المعمرة الأخرى وتحولت دول إفريقيا إلى الزبائن الرئيسيين لها.
هذه الأعمال الإفريقية الشاقة وهذه الأسواق المفتوحة كانت تتناقض مع البناء السياسي الذي أقامه الإفريقيون الجنوبيون البيض العنصري، حيث لم يُسمح للسود إلا بأعمال محددة ومُنعوا حق المشاركة السياسية وحق المُلكية، إضافة إلى عدم مساواتهم مع البيض في تقاضي الأجور وعزلهم في مناطق ومساكن خاصة، فحكمَ أربعةُ ملايين أبيض بقية السكان البالغة تسعة وعشرين مليوناً.
ولكن القوى التقدمية وخاصة جماعة الحزب الشيوعي لجنوب إفريقيا الذي أسسه المثقفون الأوروبيون في بداية القرن العشرين لعبت دوراً طويلاً في التصدي للسياسة العنصرية، والتحضير للتحول الديمقراطي ولالتحام شعب جنوب إفريقيا في شعب واحد.
وحين فرض البوير العنصريون سياسة الفصل العنصري تحرك الإفريقيون خاصة للكفاح المسلح ضد النظام، فتحولوا إلى فصيل مختلف عن بقية القوى التقدمية وخاصة البيضاء التي تؤيد النضال السلمي الطويل.
وكان الزعيم مانديلا من هذه القوى الشعبية ذات الجذور الإفريقية ولكن الكفاح المسلح الذي خيض لم يكن هو المحول للتغيير، فعلى أثر سجن مانديلا الطويل تحول هذا إلى رمز وطني وعالمي فتجمعت قوى السود والبيض ضد النظام الذي غدا متجاوَزاً من قبل التطور في القارة الإفريقية خاصة والعالم.
إن ضخامة الطبقة العاملة الجنوب إفريقية ونضالاتها الإضرابية والسياسية صدّعت النظام، وأزّمته، ولم يجد سوى التحول الديمقراطي وإعادة لحمة الشعب، فكان التغيير ذا فائدة كبيرة للطبقة المالكة الرأسمالية البيضاء، كما عكس رغبة الدول الغربية في التغيير السلمي الذي يحافظ على أكبر رأسمالية متطورة في القارة بدلاً من تسليمها لليسار الإفريقي وهروب الأقلية البيضاء.
التغيير أضفى تحولاً سياسياً على البلد ولكن التغييرات الاقتصادية والاجتماعية لصالح الأغلبية الشعبية مشت ببطء، فغدا التحول العميق يتطلب انصهاراً أكبر للسود والبيض في بنية اجتماعية واحدة.
أسَّس مانديلا التحولَ الديمقراطي الوطني العام، وتحتاج التحولات العميقة في أوضاع الشعب العامل في غالبيته السوداء إلى نضال أكثر تطوراً وزعماء اشتراكيين ديمقراطيين ذوي صلات بمختلف طبقات الشعب.
مانديلا والصراعُ الاجتماعي في جنوبِ إفريقيا
انتمى نيلسون مانديلا إلى عضوية الحزب الشيوعي لجنوب إفريقيا وإلى عضوية لجنته المركزية، ولهذا فقد ثمّن الحزبُ دورَه المذكور ودوره في تأسيس وقيادة حزب المؤتمر الإفريقي قائد الثورة السياسية ثم المسلحة ضد نظام الفصل العنصري.
لكن سياسة النضال العسكري التي انتهت بالفشل وحجَّمت دور الجماهير الشعبية في النضال عكست اختلافات وصراعات عميقة في تطور دولة جنوب إفريقيا وقد رثى الحزب مانديلا بالقول:
«لكن المصالحة الوطنية بالنسبة إليه لم تكن أبداً تعني تجنب التعامل مع التفاوتات الطبقية وغيرها من التفاوتات الاجتماعية في مجتمعنا، كما يريد البعض إيهامنا في الوقت الحاضر. فقد كانت المصالحة الوطنية بالنسبة إلى مانديلا منبراً للعمل من اجل تحقيق هدف بناء مجتمع المساواة في جنوب إفريقيا، مجتمع متحرر من وباء العنصرية والنظام الأبوي والتفاوتات الفاضحة. كما أن المصالحة الوطنية الحقّة لن تتحقق أبداً في مجتمع لا يزال يتميز بالفجوة المتسعة من اللامساواة والاستغلال الرأسمالي».
لقد عكس البيان تناقضات عميقة في وعي اليسار وفي مجمل التطور الاجتماعي الجنوب إفريقي.
فقد ظهر مجتمعان في هذا التطور، الأول هو مجتمع البيض، الذي سيطر على الزراعة واستخدم السكان السود في تكوين الريع، كما استولى على مُلكية التعدين في الماس ثم الذهب ثم صناعات التعدين المختلفة، وأسس بهذا رأسمالية بيضاء قوية متطورة، يرفض بعض قادة اليسار الإفريقي اعتبارها حتى في مستوى رأسمالية البرازيل.
استيلاء الإفريقيين البيض على المدن ومنع الاندماج بين البيض والسود، وتشكيل تلك الرأسمالية المتطورة أدى إلى تدليل الفئات الغنية البيضاء ومعهم شرائح الهنود، حيث سادت الامتيازات بينهم، وبحسب إحصائيات البنك الدولي يحصل أفقر الفقراء السود وهم 40% على أقل من 4% من الدخل الوطني، بينما يحوز 10% من أغنى أغنياء البيض على 51% من الدخل الوطني.
هذا الوضع وجه قيادة المؤتمر الوطني الإفريقي إلى شنّ الكفاح المسلح بدءًا من أوائل الستينيات، وغدا مانديلا رئيساً للجناح العسكري في قيادة المؤتمر، وفي 1962 تم اعتقاله، وفي عام 1964 تم الحكم عليه لتخطيطه لعمل مسلح بالسجن لمدى الحياة.
العملُ المسلح حوصر من قبل الدول الإفريقية العميلة للبيض ولم تستطع المجموعاتُ المسلحة أن تتغلغل في جنوب إفريقيا، وتعرض بعضها للتصفيات، كما أن انقطاع هذه المنظمات العسكرية عن السكان قاد التنظيم ككل إلى المغامرة والانفصال عن الزخم الشعبي، ولهذا فإن سجن مانديلا الطويل كان وجهاً لضعف هذا النضال وهزيمته في النهاية. وكان قادة الحزب يذهبون إلى فيتنام ويرون التجربة هناك ولكن بدون توظيف لها.
ولكن الصفقة المحلية والغربية لإنقاذ النظام في ظل أزمته التالية، خلقت نظامين متناقضين في الدولة التي أزالت التفرقةَ العنصرية وتحولت إلى دولة ديمقراطية. فقد بقيت الأقليةُ البيضاء الطبقةَ الحاكمة في مجال الاقتصاد، فيما غدت قيادة المؤتمر الوطني الإفريقي قيادة سياسية تتأثر بالاقتصاد الرأسمالي الأبيض ونفوذه، وكانت إمكانيات الطبقة العاملة السوداء ومؤيدوها من العمال البيض لا تسمح بالتأثير الواسع على النظام الاقتصادي القوي.
وهكذا عبّر انفصال مانديلا عن القيادة إلى غياب الدرس العميق لكيفية استثمار زمنية الحرب المسلحة في التطور السياسي الاجتماعي للأغلبية العاملة والفئات الوسطى المؤيدة، والتي لم تستطع أن تكون حتى طبقة وسطى من الملونين.
ومثلّت صراعاتُ القادة وتبدلاتهم في قيادة المؤتمر الإفريقي بتهم الفساد طبيعة الازدواجية في المجتمع، مثلما جاءت مشكلاتُ عائلة مانديلا وصراعاتها، معبرة كلها عن غياب التراكم الديمقراطي والعلمي في قيادات السود، وعدم قدرتهم على تكوين قيادة جامعة بيضاء وسوداء لجنوب إفريقيا الموحّدة الديمقراطية.
وبقيت جنوبُ إفريقيا ذات أغلبية فقيرة وأقاليم غنية مرفهة وأقاليم معوزة، وهي تتوجه نحو صراع ثنائي عميق انشطاري يؤسسه اقتصادٌ رأسمالي متطور في أقاليم المدن الكبرى واقتصاد ريفي متخلف في البقية من جغرافيا الدولة.
ويعتمد قادة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي على مقولة بناء رأسمالية دولة يقودها السود سياسياً واقتصادياً تربط قواهم في العاصمة بالأرياف، ولهذا يقوم أحدُ قادتهم البارزين بمدح الاقتصاد الصيني ونموذجه، وخاصة مع تحول الصين إلى أكبر مستورد لجنوب إفريقيا.
January 13, 2024
أحمد الشملان : كتب ــ عبدالله خليفة
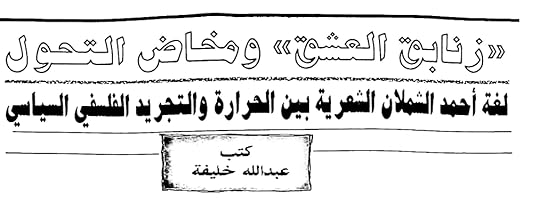
للشاعر أحمد الشملان تجربة طويلة مع الشعر، وقد تقطعت وتلونت عبر السنين، وفي ديوانيه الاثنين (زنابق العشق)، و(الاخضر الباقي) بعض شواهد وثمار هذه التجربة الطويلة المضنية، ولعل الديوان الأول (زنابق العشق) أكبر الشواهد على معاناته وصبره في خلق الشعر، وقد كتب الديوان في ظروف خاصة، تجعل من كتابة الشعر عملية صعبة مضنية، ولكن متأنية ومعمقة، بخلاف الديوان الثاني (الأخضر الباقي)، حيث تتسم القصائد بالقصر والومضة السريعة ويعكس لحظات حياتية متبدلة.
في الديوان الأول نجد مطولات، يمكن أن تمثل قصائد مهمة في تجربة الشعر البحريني الحديث مثل (المخاض) و(زنابق العشق) و(افياء الشنفري)، وخصوصاً القصيدة الأخيرة، ذات النفس الملحمي، التي تتجه لتكوين صوت تاريخي – معاصر، وتلبس قناعاً تراثياً تشاهد فيه الوقت الراهن، عبر تحولات معقدة، وتلونات خصبة.
الديوان الأول يمثل خبرة طويلة وتجارب متعددة متلونة، وككل التجارب يحوي الإيجابي والسلبي، عناصر الشعر والنثر، التلقائية الشعرية والنحت الأيديولوجي. ونحن سنحاول هنا ان نلقى بعض الملاحظات السريعة على جوانب رئيسية في الديوان الأول، مستعرضين قصيدة واحدة، بشكل ملموس.
في قصيدة (المخاض) ص 64، نقرأ قصيدة بضميرين، ضمير (النحن)، ضمير المرأة، الحبيبة، الأرض، التغيير والتحول أيضا.
ضمير النحن، ضمير الشاعر، هو المخاطب للمرأة الحبيبة، المتغرب عنها، المشكل لها، وهي المرأة الرحم، الأرض، القابلة للتشكل والولادة، بنتاج الفعل الذكوري، التغييري، القادم.
هذان الصوتان ينفصلان، يتغربان، يتوحدان، في توليفة شخصية – جماعية، يتوحد فيها العام والخاص، الطبيعي والاجتماعي، السياسي والعاطفي.
في البدء يقول (كاشفينا/ قادمون نفضح السر/ وجرحنا منفطر/ غابات حزن/ ومروج/ ومدينة/ رفعت استارها تنادينا/ عناقيد النساء في النوافذ / ترتشينا).
فإنه يجسد اللحظة الأولى للعلاقة بين صوت الشاعر، الجماعة، وصوت المرأة – الوطن – الأرض. إن الشاعر قادم لقول مثير، لفضح الأسرار، التي هي جراح المدينة الحزينة ومروجها.. فهو لا يأتي لرشف قبلة فحسب، بل لفعل تغييري عام، أو قل إن فعل الحب الشخصي، وفعل التغيير العام، يتوحدان في فعل واحد هو الخصب، المقابل المضاد لحياة الموت والحزن والجفاف. فكل اشياء المدينة واحزانها وبطون النسوة، تنادي فعل الخصب الذكوري، التغييري القادم.
وهذه اللغة الشعرية تستفيد من أجواء القصيدة التموزية، ذات النسق المعروف، بامتداداته الاسطورية والية وعيه الخاصة.
وتبدو اللغة الشعرية، في المقطع المذكور، مترددة، بين التعبير الأول، والتعبير الأخير. حيث هو في الأول (كاشفينا)، مما يعطي المرأة، الارض، كل الفعل والبرح والحقيقة، في حين يبدو التعبير الأخير (ترتشينا) قلقاً، ولا أعرف كيف تمت الصياغة هنا، لأن الفعل أصله (أرشت) فينا، بمعنى امتدت العناقيد فينا، فصرنا منها وامتداداً لها.
إن الشاعر – على ما يبدو – يعد صياغة الفعل صياغة خاصة به، لكنها صياغة قلقلت المعنى، في حين أنها كانت حرية أن تفجره.
لكن حسب تدفق المعنى، تناسقت الكلمة الأولى والأخيرة، فغدت مكاشفة المرأة الوطن، أساسية في خلق فعل الكلام – العمل القادم، فامتدت الذكورة في الانوثة خصباً، وعناقيد، وافراحاً، وصار الفعل التغييري تبديلاً للحزن والموت.
وإننا نجد هنا المسافة الديمقراطية بين الرجل والمرأة، بين التغيير والوطن، حيث لا يمتلك قطب السيادة، بل يتداخل القطبان، ويلتحمان عبر عملية تأثير متعددة الجهات.
لكن هذا التوحد الجماعي سرعان ما ينفصل، فتغدو المرأة ـ الرمز إنسانة ما، ويغدو الصوت الجماعي، صوت الشاعر نفسه، يبدأ (الخاص)، رحلته المتفردة، فبعد أن كانت المرأة طيفاً، أو كاهنة. وهذا هو نسق القصيدة التموزية، قصيدة البعث الأسطوري في نموها. وبعدها يتوحد الشاعر بالشقائق والحرائق، ويتدثر بالماء، و يُبعث نبياً، وتتوحد أشلاؤه بالمرأة، تربة تنبت اشجاراً وينابيع، وهي تمر بما يشبه دورته التموزية الاسطورية، فتصير بين الحواريين – تلاميذ المسيح – وتدخل الموت، حين سكن يونس، وتغمر الأفلاك، تعود في نهاية المقطع، لتتحدث بصوتها الخاص، بلغتها الأنثوية، لا كرمز أسطوري يطرف بعوالم غريبة كامرأة: (زغرد النهدان قبل التاسعة / وعلى حفيف العاشرة/ ترملت).
هذا النزول الحاد للأرض، للأشياء اليومية، للمرأة بعمرها، وتكوين جسدها، فيه مغايرة للعنصر الاسطوري التموزي، أنه حكي لليومي، أنها التفاتات لشعر الحياة، لا لشعر الأسطورة.
لكن الشاعر لا يتوغل أيضاً في الصوت النسائي، ليمنحه سماته الخاصة، نوافذه، ثيابه الذابلة، حاراته الحزينة، فسرعان ما تعود المرأة الى التحول رمزاً، الى شكل الأرض والتاريخ، ويعود هو بدوره الى رمز الخصب، المفارق، البعيد، الناضح غربة وحزناً، المتحول اشكالاً وظاهرات طبيعية وكونية واجتماعية.
إن هذا التردد الخاص والعام، رغم اشكاليته، يمنح الرمز المجرد أنسنه وظاهرات ملموسة ويغنيه عبر التلون وإضفاء المشاعر، لكن تراكم التردد ونموه الكمي، لا يخصب القصيدة بتحولات جديدة، بل يؤدي إلى إطالتها وتشتتها.
فالصوت النسائي، على سبيل المثال، يتنهد، ثم يوقظ الشمس، ويهاجر ليمنعها من الغروب، ويمنحها التوهج، لتمنحه الشمس بدورها الحمرة، من أجل نمر وبقاء الشاعر، الطفل، الصوت المتواجد داخل رحم الأرض، لكي يدفأ، ويقرأ التشريق والتغريب، وكذلك انعطافات الفصول، وليضع النقطة حيث تعدو الفاصلة.. هذه العملية الفلسفية الفكرية التراكمية تصير عقلانية، تحكمها أدوات النثر من ربط ووصل وتحليل. في حين كانت العلاقة واعدة وثرة، عبر ادوات الشعر التي ظهرت في البداية، مكثفة، مشعة.
ويستمر الشاعر في (نثر) هذه العلاقة الفكرية، عبر صور متعددة، تحكمها أدوات الربط النثري والعقلنة، لكنه يتخلى في أحيان عديدة، عن هذا الطابع العقلي النثري، ليصور العلاقة بشفافية عاطفية غنية، كالمقطع التالي:
(وحيدة رأيتها/ واقفة على جدار الغمام/ توزع الضوء البنفسجي طحينا).
ان الشاعر حين يستجيب لتدفقه الانفعالي، وينسحب من مناخات القصيدة التموزية، وتتدفق الصور المعبرة، المنتزعة من ظاهرات الحياة اليومية والمعاناة الحقيقية، ينمي العملية الشعرية الابداعية، وهو يفعل ذلك مراراً، حين يدع الصوت النسائي يعبر عن هواجسه الشخصية، ومرارة الانتظار، أو حين يكمل الصوت الرجولي، اللوحة من الجانب الآخر، عبر عذاب الغربة والنفي والبرد والجوع والحب، حينئذ تنمو اللوحة الشعرية.
ولكن حين يحول هذه العلاقة الشخصية الحميمة الغنية بدلالاتها وذاتها، ويريد (ربطها) بعوالم أخرى، فيسيطر عليه هاجس رسم اللوحة السياسية، يبدأ (النثر) في الاستيلاء على عالم الشعر.
حين يقول (قفي نتكئ/ صخرتين بلا قرار/ لنبذر العصافير جفونا/ تبدد البكاء)، يشكل الشعر، رغم انه بعد لم يطلق ذات الداخلية، بهواجسها وضعفها وقوتها، ولا تزال صورة القوة الحديدية والعطاء اللامحدود تظلل اللوحة، ولكن عندما يقول (هاجرت أمنعها الغروب/ أمنحها التوهج/ فتمنحني حمرة للذي بالرحم لكي يدفأ)، فالصورة ذاتها منتفاة، وغير شعرية، وتأنى كثرة أفعال الربط وروح التحليل والتفسير، لتبعدها عن روح الشعر.
وجرد الحالة الشعرية القوية، ووجود الحالة النثرية العقلية، جزء من تراكم بنيتين شعريين متناقضين. الأولى نتاج بنية الشعر الحياتي، التي تنبع من ظاهرات الواقع الحقيقية، من هواجس الشاعر واحلامه والامه، وتضاريس الحياة التي يصارعها ويحولها.
والثانية هي بنية الشعر الاسطوري ومناخاته الفكرية العقلانية، ثم امتداداته السياسية في عملية التبشير الأيديولوجي.
في بنية الشعر الأولى ينمو الشعر ببساطته وتألقه، ويندفع من مسام الصوت الشعري، وهذه البنية لم تتطور بشكل واسع في القصيدة نظراً لخنق الأيديولوجي للشعري.
وفي البنية الثانية يصعد الشعر نحو عالم الاسطورة والربط السياسي.. مما يقلل من تنامي البنية الاولى.
لنأخذ المقطع الأخير في القصيدة لنرى هذا الصراع بين البيتين:
(زنابق هنا / وهنا زنابق / لقحيها بالرياح.. بالبحر/ بأطلال النخيل/ وغداً عند الصقيع/ يأتيها المخاض/ فتأخذ شكل أحلام البكارة / شكل اقمار السهر/ قبل السفر/ لتنداح الإشارة) ص 85.
فألم الأرض، وعذاب الحبيبة، يتشكل عبر بذور هنا وهناك، لتغدو في خاتمة المطاف ربيعاً وانفجاراً. ويبدو التسلسل العقلي المنطقي واضحاً، والمقدمات تأتي بعدها النتائج الحتمية.. هذه العملية تمثل ادلجة فكرية وتضعف تنامي الشعر المليء بالعواطف الحارة والتحولات والنماذج لا القوالب.
وحتى في هذا المقطع التقريري تبدو امكانية الشاعر قوية في الصياغة وابتكار الصورة وخلق الإيقاع الموسيقي، ولكنها لم تأت (عفوية)، وهو يمتلك العديد من النماذج والمقاطع والقصائد – القوية المعبرة، ولا نستطيع في هذه اللمحة القصيرة أن نتجول فيه كلها.
January 12, 2024
عبدالرحمن رفيع : كتب ــ عبدالله خليفة

على خُطى الشعر العامي الساخر ودعابة بيرم التونسي الجارحة الفكهة، توغل الشاعر عبدالرحمن رفيع في عالم فريد، خاص، بسيط وعميق، شفاف ولاذع. استطاع به أن يكون شاعراً متميزاً.
واتجاه عبدالرحمن رفيع لشعر السخرية المرُة، والنقد الضاحك المؤلم، هو طريق شقه منذ سنوات بعيدة، وتمرس فيه وأبدع، ولكن هذا الدرب لم يرض عنه النقد والأدب الجامد، في حين استقبله الجمهور بترحاب كبير .
لم هذه المفارقة الغريبة ان يكون رفيع مطروداً من دائرة النقد والضوء الادبي، ومحبوباً لدى السامع والقارئ ؟
ليست اشعار رفيع ساذجة ومسطحة، ولا مقعرة ومفتعلة، بل هي لغة البساطة الشعبية التي لا يستطيع أي فنان أن يصل إليها إلا بشق النفس.
لماذا استطاعت هذه اللغة أن تكون معروفة وشائعة لدى رجل الشارع؟ ما هو السر وراء هذا التغلغل والبقاء في الذاكرة العامة ؟
في قصيدة عبدالرحمن رفيع، هناك عادة حكاية، قصة ما، تنبثق منذ أول كلمة لتتنامى في معمار خاص، ويتيح هذا البناء القصصي، للشاعر، تكوين مشهد مرئي حي أمام عين المتلقي. وبفضل هذا المعمار والبناء، تنتقل حرارة ووهج الحكاية إلى ذات المتابع.
وضربات عبدالرحمن رفيع بفرشاته الشعرية – القصصية دقيقة وسريعة وموحية. وهي تبني بلا توقف هذا المعمار الحدثي القصصي بلا إبطاء او تعثر.
في قصيدة (الايسي العظيم) – راجع ديوان (بحر وعيون) دار ذات السلاسل ص 69 – نرى هذا التكنيك السريع المعبر:
[إخواني وأهلي يشتكون/ حرّ شديد ما يهون/ حبه ورا حبه العرق، ينزل او يدخل في العيون/ قلت: اشتريلهم مروحة/ تنفعهم في ليل وضحه] .
انه منذ الكلمة الأولى يدخلنا أجواء الحكاية، ويصور أحوال الشخصيات، بلمحة سريعة، وبصور دقيقة مكثفة. فالحر حبات من العرق تنهمر وتتوغل بملوحتها في العيون، وعبر هذا الرسم المصور دخلنا اجواء العائلة الفقيرة المعدمة، حيث المكيف الجديد حلم من الاحلام. والراوي/ الشاعر، يصور رحلته نحو هذا الشراء للمكيف المستعمل، وكل لقطة من لقطات نمو الحكاية هي لفتة ساخرة، وضحكة نازفة، ونقد عميق وفكه للمجتمع.
[صبريت على الجوع والقهر/ والعيشة ويل/ لين ما جمعت جم نوط خضر/ وقالوا لي سيل/ واتوكليت].
هكذا تتنامى الحكاية وسط دغل الحياة الصعبة، وتظهر لعبة المفارقات بين البطل الفقير والسوق المليء بالمال والبضائع. وحين يشتري الراوي المكيف، يتحول هذا إلى بطل له سماته وشخصيته الضخمة المنتفخة ولكن الفارغة والمعطلة!.
فقد أحضر المكيف الضخم إلى الحي الفقير، وتجمهر الناس حوله، وكان ثقيلا، حمله خمسة رجال، وكادوا يسقطون على السلم، ثم اتضح ان المكيف ليس سوى حديد خردة لا ينفع بشيء!.
فن خلق الحكاية بأجوائها المصورة الملموسة، وبومضات من اللغة هو ما يشد القارئ إلى شعر رفيع .
لكن هذه الحكاية لا تتجسد عبر طريقة جافة، بل من خلال النكتة والمفارقات. فحتى أثناء وصف السوق الذي يندفع فيه الراوي، نلمح هذه النكتة السريعة
[سوق المنامة سوق عجيب / اتلاقى فيه ما تشتهى/ بس خرخش المخبه وييب/ كل المحلات تعشقك/ ان كان في مخباك الحبيب!].
إن من ملامح تجربة رفيع هذا التصوير الدائم لعالم المال والأغنياء فالسوق والنواخذة وتجار الأسهم دائما حاضرون متجسدون، ضيقو الأفق، بخلاء، نهمون، مندفعون إلى الثروة.
ولكن في هذه القصيدة (الايسي العظيم)، ليس ظهور السوق، سوى أمر عابر. ولكن يشكل تضاداً مع عالم الراوي الفقير الباحث عن مكيف مستعمل.
وتنامى الحكاية يتم عبر صراع فكاهي وساخر، فالراوي يتصارع مع هذا المكيف الضخم، ويحلم ببرودته الساحرة، ثم يصاب بالخيبة لفواتيره وتصليحاته وموته!.
إن النكتة هي في الموضوع ذاته ولكن هذا الموضوع العادي يحمل قضية عميقة، حيث يتبدى الصراع بين الإنسان البسيط والظروف الصعبة حوله. فليس المكيف سوى تجل لهذه الظروف. وتركيز الأمر عليه، هو اللغة الساخرة، القادرة على التغلغل في الشعب، وكشف حياته الصعبة.
واللغة التي يعتمدها الشاعر هي لغة الحديث اليومي، ومن هنا جاءت جملتها المنسابة، بلا افتعال، وصورها المأخوذة من مجريات الحياة، ومن هنا تغييرها للقصيدة الكلاسيكية المقفاة، مع الحفاظ على وحدة التفعيلة، والتزاوج بموسيقى خارجية، وقافية مرنة ومطواعة لتشكيل الحدث القصصي – الشعري.
وتتداخل نزعتان في شعر رفيع، أولاهما رومانسية عذبة، رقيقة شفافة، تعبر عن حس الشاعر العميق، وشعوره بغربة كبيرة في هذا العالم الحديدي الغريب.
ان الماضي، يلح إلحاحاً شديداً على الشاعر. ومن هنا هذه الصيغة اللغوية المتكررة، أو هذا الاستفهام الفاجع بتغير الزمن: (تذكرين؟)، وهذه المفردات والصور الدائمة عن السفن واللؤلؤ والبحر وبيوت السعف والنوافذ الخشبية والحارات القديمة.
[أحن للجبهة السمره/ أحن للوزه والبسره/ أحن للصوت واليا مال والشيلات/ والسمره].
إن الوطن، كثيراً ما ظهر لديه، كرمز يعيش في الماضي، متوحداً مع ركائز البحرين القديمة، والتي تتعرض لرياح العصر العاصفة. ومن هنا يوجه بصره إلى ذلك الماضي الجميل المندثر، بحرقة.
وهو يدرك أن هذه التغيرات الحادة الفاجعة، وعلاقات الغربة المتفاقمة، وروح المال القاطعة للحم الإنساني. وهذه هي النزعة الثانية، إنها النزعة النقدية الإنسانية، التي تطور الوعي الرومانسي، إلى تغلغل سافر في العلاقات البضاعية المتفاقمة. ولا يوجد في شعرنا من استطاع أن يتغلغل في الحياة الرأسمالية الحديثة ويعبر عن نتائجها الروحية كما في شعر رفيع. عبر بساطة ساحرة و لغة شعبية فكاهية.
[وشب الفريج طابوق / والناس عنه اتفرقت / ودش السكيك السوق/ والآدمي مثل التنك / يحلى ويصير سكراب / بيعوني في سوق الحراج!].
إن رومانسية رفيع لا تقف عند الحلم بالماضي، بل تقرأ تضاريس الحاضر وأضلاعه الحديدية الحادة.
يحيى حقي : كتب ــ عبدالله خليفة

رحل الكاتب القصصي الكبير يحيى حقي عن عمر بلغ 87 عاماً، كتب فيه العديد من أعمدة القصة العربية، مثل «قنديل أم هاشم» و«صح النوم» و«عنتر وجولييت» «أم العواجز» إضافة إلى عشرات الدراسات النقدية والفكرية واللوحات.
ونحن سوف نقوم هنا باستعراض جانب من مجموعته القصصية «عنتر وجولييت» وملمح خاص منها، هو كيفية بنائه للقصة القصيرة، و أين تصل رؤيته وأبعادها.
إن أهمية يحيى حقي الأدبية الكبيرة تكمن في صياغته قصة قصيرة بالغة الروعة والجمال، فيها كثافة تعبيرية ودلالية عميقة، وتكاد أن تكون كل قصة قصيرة هامة كتبها أن تكون رواية مكثفة.
ستجد فيها عناية فائقة باللغة، بسلاسة الجملة، وكأن اللغة مجرى مندفع بهدوء وفخامة، وثمة جهد جبار لترويض هذه الأداة اللغوية، وجعلها تبدو عادية، غير مفتعلة، ومع هذا فهي أخاذة جميلة ويحاول يحيى حقي، في أحيان كثيرة، أن يطوع اللغة العامية، أن يبحث عن مفرداتها الجميلة، القريبة من الفصحى، ليدخلها في سرده. تماماً مثلما يفعل في بنائه القصصي، معطياً أوردته الداخلية العميقة، للناس لأبناء الحارات، فترى صورهم وحيواتهم ومعاناتهم داخل نسيجه اللغوي – المضمونى، فهي قصة عميقة التشكيل، في ذروة جدالية، وهي أيضاً بسيطة التركيب، تمشي حية على الأرض، مفعمة بعطور الأمكنة وظلال الأشياء.
ثم هي أيضاً مزيج غريب وفريد من التراجيديا والكوميديا، تتداخل فيها المأساة الحادة والضحكة المجلجلة، دون أن تتحول إلى ميلودراما مفتعلة، تدهش سخرياتها اللاذعة داخل أقبية الحزن.
فيحيى حقي هو «ابن البلد» الذي مهما نهل من علوم أوروبا وفنونها المختلفة، جزء من الحارة الشعبية، لا يحطم قناديلها القديمة المقدسة، بل هو يضيئها بزيت الحداثة، تعال معي إلى أهم ملامح قصص «عنتر وجولييت»(١) لنأخذ الخط الداخلي المتنامي بينها.
قصة (السلم اللولبي) ص 35 -37، تدور حول شخصيتين، الأولى هي (السلم اللولبي) نفسه والثانية هي (فرغلي صبي المكوجي) وإدغام المؤلف لهاتين الشخصيتين الجامدة والحية، في توليفة قصصية حديثة واحدة، يعبر عن هذه الجدلية العميقة بين الإنسان والمكان، الذات والعالم.
وهو حين يبدأ وصف شخصيته الأولى، السلالم، نحس بهذه الأحجار الجامدة، وهي تتحول إلى مخلوقات حية، ولكنها شرسة، تفترس هؤلاء البسطاء الصاعدين إلى العمارة من زواياها الخلفية. إن المؤلف يسوق عشرات التشبيهات لوصف هذه السلالم التي تذكر الراوي بـ(تفنن محاكم التفتيش الإسبانية في ابتداع أمكر وسائل التعذيب الوحشي وأخسها) وحين يتابع خطى الخدم والباعة وتجار الروبابيكيا وصبيان البقال والمكوجي (أنهم احفاد العمال بناة الأهرام).
هكذا تتحول السلالم إلى لوحة طبقية ساخرة، مؤلمة. فسلالم مقدمة العمارة الأنيقة، النظيفة، هي من نصيب سكان العمارة وأصحابهم، أما سراديب محاكم التفتيش فهي من نصيب أولئك العمال.
وتناغم الوصف ودخوله إلى تفاصيل المكان، ليس مقدمة تقريرية بل هو متابعة لبطله الثاني (فرغلي صبى المكوجى) الذي يركض دوماً، طوال النهار. على هذه السلالم الخلفية، التفتيشية.
والكاتب يتوغل في أعماق الصبي فرغلي، عبر هذا الوصف الدقيق الفكه لحركاته وملابسه وهيئته فأغلب مقاسات ملابسه كبيرة عليه، إنها مأخوذة من الزبائن الذين تخلوا عنها. وهو أيضاً عميد أسرة ريفية يرسل إليها معظم أجره.
هكذا نرى أسلوب يحيى حقي وهو يتوغل إلى البناء والشخصية، متابعاً تفاصيل دقيقة مذهلة في تكوينها الخارجي — الداخلي. وهو سوف يدهشنا بقراءته لجغرافية المكان والذات الإنسانية وعلاقاتها الصراعية والتآلفية.
بعدئذ يدخل المؤلف إلى الحدث. بعد هذه الفرشة السريعة للمكان والبطل. فقد غافل (فرغلي) البواب ذات يوم وأراد أن يكسر عالم السلالم الطبقي التقسيمي الحديدي، وتوجه من السلالم العادية وليس الخلفية، وحين فتح باب الشقة اندفع إليه (ركس) كلب السيدة وعضه. كان هذا عقابه على اختراقه الناموس! إن هذا الحدث الصغير سوف يفجر كل جزئيات الموقف القصصي. فسوف نرى فرغلي قبل حدوثه، وهو يلاحظ (ركس) من باب المطبخ، كما أن للسيدة صاحبة الشقة خلفية خاصة، فلديها صديقة صاحبة كلب مماثل عض صبياً آخر، فعانت من شكوى أهله للبوليس.
لهذا حاولت السيدة عبر سياسة ماكرة، أن تهدئ فرغلي وتلغي ثورته وحقه، فأعطته «نصف ريال» وشكولاته، وكانت حنونة أيضاً بفعلها العفوي، حتى ظن أنها من الممكن أن تعطيه نصف ريال آخر. خاصة بعد أن أصيب بحمى، وجثم في الغرفة الجماعية، وهناك، في مرضه، أشتاق إلى دكان الكواء، وتذكر حتى الملابس التي يحملها وتعطيه إنطباعات غريبة عن البشر.
لقد رفضت السيدة أن تعطيه نصف ريال، لتعوض أجره الناقص، فصرخ في نهاية القصة (أيه يا خويا الناس دول.. ما يحنوش على الواحد إلا إذا الكلب عضه).
هكذا يغوص يحيى حقي في حياتنا، عبر نموذجين متداخلين، لنشاهد لحمنا الداخلي، التركيبة الاجتماعية المتناقضة اللاإنسانية، بشفافية ساخرة حزينة.
إن القصة تقام فوق سلسلة من التضادات الاجتماعية المختلفة، فأهم تضاد هو بين فرغلي والسيدة وكلبها. فحين يعيش فرغلي من عمله ويصرف على عائلته، ويعيش أسوأ من كلب، فإن (ركس) يعيش حياة باذخة. ولكن هذا التناقض لا يتحول إلى صراع فردي، بل هو يتعمم ويتنمذج في تركيبة واسعة.
إن التضاد بين فرغلي / السيدة، يكشف عن التضاد الأوسع بين الناس، الشعب، والطبقة الوسطى. فثمة من يلقون ملابسهم المستعملة، ومن يلبسونها، من يحضرون من العزب والقرى ومن يستخدمونهم في المدينة.
إنها تضادات متعددة، الصبي / السيدة، الناس/ الأغنياء، السلالم الخلفية / السلم اللولبي، القرى / المدينة، العاملون / المستغلون، إلخ..
إن هذا الصراع مراقب دائماً من قبل الكاتب، وهو يصدر المشاهد الامامية والبارزة منه.
فالقصة القصيرة لا تتيح مثل الرواية، التوغل في هذه التضادات. ويحيى حقي عموماً يقف على ضفة هذه التضادات، ولهذا فإن بنيته القصصية دائماً قصيرة، في حين أن نجيب محفوظ، يتوغل بعيداً في تجليات هذه التضادات. ولذا كان روائياً.
وإذا كانت القصة تقوم فوق تضادات متصارعة، تكشف عن بنية غير إنسانية عامة، فإن الأسلوب القصصي يقوم على الجمع بين التضادات الأسلوبية ويدمجها في بنية فنية راقية.
فنجد التضاد واضحاً بين الفصحى، العامية، البساطة / العمق. الروح/ الشعبية/ الرؤية الحداثية إلخ..
إن اللغة أحياناً تتغلغل بين فصحى جميلة شعري،. و عامية حاراتية بسيطة، لكن الكاتب بضفر بين الجانبين للغة، فتجد أن نمو السرد البليغ، على تضاد حاد مع الحوار العامي، الذي يتحول إلى لغة جميلة. إنه هنا قنديل أم هاشم الذي ينتزع الموروث والحياتي ليوظفه في بنائية جمالية عربية صاعدة. إنه التحديث اللغوي وإعادة خلق اللغة من عنصريها المتضادين، المتحدين أداء ووظيفة وسيرورة تاريخية.
وهكذا أيضاً تتحول بساطة العرض والحدث ومرافقة الراوي الظاهرة للشخصيات العامية، إلى دخول في أعماق التجربة، ورؤية ذلك التضارب العميق بين الشعب العامل والبرجوازية وتجاوزه في إنسانية شفافة وإيماءات وليس عبر التغلغل التصويري الموسع كما فعل نجيب محفوظ.
وفي قصة (سوسو) ص 38 – 50، نجد تقنية عالية، ونذهل لقدرة القصة القصيرة هنا، أن تحمل كل هذه الترميزات. وأن تتحول كذلك إلى قصة ممتعة رائعة.
هنا نجد ذلك النمط الأخر من القص. حين تتوجه القصة لا للتعرية الاجتماعية. بل للوصول إلى تحليل للنماذج الروحية – النفسية – أي أن القصة، هنا ترتفع عن القاعدة الاجتماعية التحتية، لتتوغل إلى صميم الظاهرات الروحية، التي هي موضوع الأدب الإنساني العملاق.
يكثف الكاتب اللحظة القصصية هنا، مكاناً وزماناً، فهي ليست سوى مكالمة من صديق محسن، الذي هو راوي القصة، يدعوه لحضور حفلة عيد ميلاد ابنه الصغير (سوسو) ذي الأربع سنوات، المريض بالداء المغولي. وبين الذهاب للحفلة، وسقوط الابن المحتفى به من فوق الشرفة، يكمن زمن القصة وحدثها وأمكنتها المتعددة الكثيرة.
إن الراوي محسن يعيش في هذه اللحظة، حواراً داخلياً مطولاً، يعري فيه حياته كلها، دون أن يظهر هذا العرى الكامل له.
إن أعجوبة القصة تكمن في هذا العرض / التعرية.
إن ذلك يحدث عبر تصادم النموذجين الرئيسيين في القصة: محسن الراوي، الموسوس. العاجز، ابن المرفهين، الذي ولد من أب شيخ وأم تقضي معظم أيامها في المستشفى، وبسيوني ابن الريف الفقير، الضحوك الانبساطي، الذي يقبل على الحياة بقوة وحب. يتزوج ابنة عمه (زينب) الهيكل العظمي، فيحوله إلى حياة مدهشة.
إن الراوي، وهو في سبيل إعداد هدية لـ«سوسو» يكشف هذا التضاد العميق الواسع، بينه وبين بسيوني.
1 — صور هذا التضاد، تبدأ منذ أيام الدراسة حتى زواج بسيوني، وتتوغل في شتى ظاهرات حياتهما الشخصية. نجد الراوي شكاكاً، يبحث عن أغلى الأدوية في الصيدليات، يصاب بالذعر من أي ممارسة جنسية، يعجز عن القيام بأي علاقة مع امرأة، في حين كان بسيوني يجلجل ضاحكاً من هذه الممارسات ومن مغازلاته الكثيرة، وتتهافت عليه النساء الغنيات، لكنه لا يقبل سوى زينب ابنة عمه، لعل هذا هو سبب مصيبة طفله المغولي. ولكن رغم هذه المصيبة فإن الطفل يتحول إلى مركز لفرح الأسرة واغتباطها، مما يجعل الراوي مذهولاً.
نموذجان متضادان، الأول مخنوق بداخله المريض، لم تستطع طاقات طبقته أن تطلق قدراته، والثاني منطلق، لم تستطع محدودية طبقته، أن تكبح انطلاقات ذاته الحيوية.
وحين يسمي بسيوني ولده المغولي (محسن) تيمناً باسم صديقه. كان هذا ترميزا واضحاً للعلاقة بينهما.. وحين يتردد محسن في شراء هدية عيد الميلاد. بين الدراجة و(الطاحونة الضخمة التي تضاء بالكهرباء وتدور أذرعتها على لحن راقص ينبعث من داخلها) فإنه يختار الطاحونة الفارغة ذات الدوران الداخلي. أو يختار ذاته الطاحنة، لا الدراجة العملية التي يمكن أن تساعد المغولي على الحركة. أو تساعده هو على المشي الاجتماعي الحقيقي.
وحين ينقذف الطفل من الطابق الرابع. في حركة مباغته من الأب الذي لا يعرف أن ابنه في صدر محسن. يكون الراوي قد حكم على ذاته بالدمار.
هكذا تقوم تقنية القصة القصيرة هنا، على موضوعية الراوي في التعبير عن حياة الآخرين، ليعري حياته، عبر بنية دقيقة من الترابط النموذجي. التناقضي والمسيطر. عليه في حبكة، مشوقة، ساخرة. حزينة. مع بث مجموعة من الرموز. لتعميق البنية مثل (سوسو) الطفل والراوي معا. و(الدراجة)، (الطاحونة)، (الشرفة والسقوط).
2 – (سوسو) يمثل المعادل الموضوعي لازمة الراوي.. وهو يناقش وينفي نفسه حين يعرض الطفل. انظر كيف يراه. (ماذا يدور داخل هذه الجمجمة، أي يد مجهولة تكتم عوائها؟ هذا الجسم المتحرك يمثل عندي خنق جبار لقوة جبارة) الخ..
!ن يحيى حقي يدخل هنا الطبقات السفلى من الوعي. معرياً نموذجه. بلا تقرير أو منولوج غامض. حاسماً بين كثافة لغة تشيخوف، ومشرط، دستويفسكي، بين موضوعية القص و«حياديته» الباردة والتوغل العميق المعري، إن القصة تصف البطل من خلال اللابطل، الصحة من خلال المرض. النضال من خلال العجز. جدلية رائعة ورهافة في اللغة والتعبير.
في قصة «عنتر وجولييت» التي سميت المجموعة باسمها، نشاهد أوسع تقنية لإبراز التناقض الاجتماعي، وأوسع عرض لذلك التضاد، الذي رأيناه سابقاً، في قصة (السلم اللولبي) اي تضاد صبي المكوجي فرغلي والسيدة، الشعب والطبقة الوسطى، الفقراء والأغنياء، وعبر ذات الموضوع.
القصة أشبه بالقصيدة، ليس في طريقة رصف الجمل فحسب، بل في هذه الشفافية الشعرية للغة، وبهاء الصورة، وكثرة التضادات المدهشة، وبراعة الاستعارات، وجمال الوصف الدقيق. لنأخذ فقط هذه الجملة التي تبدأ بها القصة:
(هو مسكن فقير، أمامه نصف سطح، تشقه – كأوتار العود – حبال الغسيل).
فمنذ البدء، نجد هذا الاقتحام السريع للمكان، عبر كثافة الصورة، في ثلاث جمل متساوية، ثم تتحول الجملة الثالثة إلى صورة شعرية، كصور (الشعر اليومي)، الذي بدأت القصيدة العربية الجديدة تكشفه.
هكذا تمضي جمل السرد، وصف للمكان والشخصيات، وسرد لحركتها وانفعالاتها وأقوالها، من خلال عين الراوي /الكاتب، بذات الكثافة الصورية الشعرية.
الحكاية من عائلة تسكن هذا البيت، وتشكل النقيض الأول. إن هذه العائلة المعوزة تعيش عالماً صعباً، لكنه حر، فليس ثمة حجاب أمام السماء أو الروح. الأطفال كبار والكبار أطفال. و«الحواديت» ليست عن الجن، بل من الحياة ذاتها. أبواب الشقة مفتوحة للأهل والجيران كوكب الام تثرثر مع الجارة الإيطالية والزميلة الغنية، يجلسون على الأرض ويثرثرون، النوافذ مفتوحة ورتاج الباب مخلوع فماذا سيجد اللص في مسكن كهذا؟ ثم هناك عنتر!! إنه كلب الأسرة. لقد صار لفقراء يحيى حقي لأول مرة كلب، لكنه على شاكلتهم حر، شفاف، إنساني، لا يطيع أحداً يحب الخلوة وعزة النفس، يكره اللعب معه.
هنا نجد «الشعب» الأسرة الفقيرة الإنسانية، المفتوحة للهواء والكلام (حيث لا سيد ولا مسود، ص 115) تعيش ضنكاً، ولكنه ضنك عام (لا يتغلغل في الراوي فيكشف تجلياته المعقدة) لكن هذا الضنك لا يتحول إلى جنة، على طريقة «ما أحلاها عيشة الفلاح» ويشكل الكلب «عنتر» المعادل الموضوعي لهذه الحياة، لهذا القطب التناقضي، فهو مشرد، فقير، حر، إنساني، شجاع..
وفي مقابل هذه الحجرة المليئة بالأولاد. فوق سطح العمارة. هناك فيلا (إجلال هانم) النقيض الاجتماعي الواضح لتلك الغرفة وعالمها الحر. فهنا نجد إجلال هانم، وهي تسيطر سيطرة مطلقة دكتاتورية، حادة وعنيفة على الفيلا. صرخات حادة على الخدم، ذوي الأسماء المختارة المناسبة للصراخ المنغم. وحيث الزوج المستعبد، وفقدان الأولاد.
لقد طور المؤلف سمات السيدة. صاحبة الكلب، التي رأيناها سابقاً. لكنها تتحول من سيدة شقة !لى سيدة فيلا. وتطورت علاقاتها السلطوية والاجتماعية فارتفعت من ذلك التنميط العام جدا إلى نموذج أكثر حيوية وعمقاً.
ولهذه الأسرة ترميزها المختلف، أو معادلها الموضوعي المغاير، وهو هنا كلبة اسمها «جولييت». فإذا كان «عنتر» هو وجه الفقراء، العبيد. الشجعان، فإنه هنا في «جولييت» الأغنياء. الأجانب. التسلط، العقم.
ولكن الكلبة جولييت ليست متل سيدتها، صحيح أن جولييت ذات شعر حرير وذهب، وعيونها وفمها تمسح بمنديل، وإذا مرضت يزورها طبيب. تعالج بالحقن الغالية، وتؤتى لنا الهدايا. تعرف كثيراً من الألعاب. الا أنها أيضا تعيش عذاب سيطرة السيدة، وتتوقع الكوارث دائماً وتصاب بالكآبة نظراً لهذه الرعود المفاجئة من السيدة.
إن تصادم الأسرتين: الفقيرة والغنية. لا يأتي عبر طريق مباشر. بل من خلال علاقة غير مباشرة، أي حين يقع الرمزان، الكلب والكلبة، في سيارة البوليس المرعبة.
إن هذه اللقطة الحديثة التصادمية الغريبة، تعيد ترتيب كل جزئيات القصة. ففجأة نجد أنفسنا أمام صراع اجتماعي. فجولييت التي تقع عدة ساعات في الحبس. تقام الدنيا على اختفائها. وتشتعل أسلاك التليفون بين الفيلا والمسؤولين والضباط، بينما يجثم عنتر في مكانه معتقلا، دون أن تتمكن السيدة كوكب، من جمع ثمن الغرامة وتركض في الشوارع هائجة دامعة.
يحيى حقي يوسع هنا دائرة الصراع بين القطبين المختلفين عبر بؤرة جانبية، إنسانية ورومانتيكية، وهو يصور تنامي الصراع واتساع شبكته وتباين عوالمه الروحية.
إن هذه القصة القصيرة تحول أن تقوم بما تؤديه الرواية، لكن لماذا تتوقف مثل هذه القصة القصيرة الساخرة، الناقدة، المحبة للشعب، عن التحول إلى روايات تتغلغل في تحليل تناقضات المجتمع؟ ولماذا لم يتوسع كشف صراع الشعب الطبقة الوسطى، وهو أساس تناقضات الحضارة الحديثة، ويتجلى بمستوياته المختلفة، العميقة؟
هل يعود ذلك إلى الوقوف المستمر للكاتب على شاطئ السؤال، عبر الاكتفاء بتلميحات وظلال (قام بتوسيعها في صح النوم) بدلاً من المشرط الحاد الذي أمسكه نجيب محفوظ، حيث أتسعت أدواته في عرضه، وتعدد بؤر الكشف وآليات الإبداع التي حصل عليها نظراً لهذا الموقف؟(2).
يخيل إلي أن استمرار يحيى حقي في القصة القصيرة، والإكثار من اللقطات الجزئية، والنقد الجانبي، ثم تحول القصص إلى «لوحات» كل ذلك كان يشير إلى أهمية العبور إلى بحر تحليل التناقضات ومستوياتها المختلفة، وامتداداتها التاريخية والترميزية.
لكن هذا لا يقلل أبداً من عظمة يحيى حقي القصصية ومواقفه، الذي يقول عنه المفكر محمود أمين العالم (.. فيحيى حقي هو ابن ثورة 1919، وهو امتدادها الفكري والأدبي والفني المتجاوز لها في الوقت نفسه، ألم ينتقد هذه الثورة لأنها لم تتحول إلى ثورة اجتماعية) (3).
ـــــــــــــــــــــــــــ
المصادر
(1) عنتر وجولييت. الهيئة المصرية العامة للكتاب. طبعة 1986، – مصر.
(2) راجع موقفه السياسي — الإبداعي عن الحقبة الناصرية في كتاب (المثقف العربي والسلطة) – تأليف سماح إدريس – وهو بحث في روايات التجربة الناصرية. دار الآداب 1992، بيروت.
(3) مجلة ابداع — العدد الأول يناير 1993، – مقالة (يحيى حقي… ناقداً).
(4) فجر القصة المصرية مع ست دراسات أخرى عن نفس المرحلة – يحيى حقي – الهيئة المصرية العامة للكتاب – 1987، – مصر.
January 11, 2024
أدب الطفل في البحرين



بدأ أدب الأطفال في البحرين، كنوع أدبي جديد، عبر انتاج خلف احمد خلف، وعبدالقادر عقيل، اللذين توجها، إلى هذا الجانب الابداعي المتميز، بعد عمل مستمر في كتابة القصة القصيرة، والطويلة، وخاصة عند خلف.
وقد اتجهت القصة القصيرة لدى عبدالقادر عقيل إلى نواح تجريبية وصوفية، مما جعل اللغة القصصية ذات تراكيب إبداعية ليست متألقة، فيما يبدو، مع قصة الطفل البسيطة الواضحة.
وإذا كانت قصة الأطفال عند عبدالقادر عقيل لم تشهد إنتاجا واسعا بعد قصتيه (من سرق قلم ندى ؟) و(من يجيب على سؤال ندى؟)، حيث واصل رحلته في القصة التجريبية وتطعيمها بمناخات صوفية،
فإن خلف أحمد خلف اتجه إلى مسار أخر، هو صياغة مسرحية للأطفال، بعد أن باشر كتابة قصص قصيرة قليلة للطفل.
وكتب إبراهيم سند قصة الطفل بمثابرة مستمرة، بدون أي تجربة قصصية سابقة، وكذلك فعل إبراهيم بشمي، الذي كان قادما من عوالم الصحافة والتحقيق، وإذا كان إبراهيم سند قد حاول أن يرسم مساراً خاماً لنفسه، جامعا بين النقد لظاهرات الحياة، والفنتازيا، مرافقاً البساطة بنحت ممرات غريبة في الحادث اليومي، مستنداً إلى الواقع المحلي بطبيعته وحيواناته وطيوره وبشره، فإن إبراهيم بشمي قد اتجه إلى نقد العادات السيئة، وظاهرات التخلف السائدة، متجها إلى مزيد من التوغل في اعماقها، عبر الأنماط الفنية، والأحداث المكثفة، المرسومة بهدف خلق التوجيه، ولكن الأحداث راحت تتسع في عوالم الماضي، متشحة بثياب التاريخ، متسربله بدلالات الحاضر. لكن سيطرة الهدف التوجيهي في قصصه، وبروز التعليمية الاجتماعية والسياسية، أوصل هذه القصة إلى ضرورة تحويل البنية، وتصوير الشخصية.
ويُلاحظ ان اغلب اعمال الطفل تتجه تدريجيا إلى طرح إشكالات البنية الاجتماعية العميقة، عبر الصعود المستمر من الجزئي إلى الكلي، ومن المحدود إلى الشامل. ويترافق هذا مع تحول طبيعة الأبطال – الشخصيات في القصص، فالبطولة المسندة للحيوانات والنباتات وعناصر الطبيعة، تتراجع لتبرز بطولة البشر، وخاصة من الأطفال والصغار.
وتكتسب اعمال خلف احمد خلف الموجهة للأطفال، دلالات هامة، بحاجة إلى الفحص المستمر، لكونها تعبر عن أبرز سمات أدب الطفل في البحرين .
فقد أظهرت هذه الأعمال أن أسئلة الأدب العامة تظل ملحة كذلك، في هذا النوع الأدبي الخاص، وهو أدب الطفل. فإذا كانت بعض المحاولات في مسرح الطفل البحريني قد استسهلت هذا النوع من الفن، إلى درجة التسطيح والتشويه الكامل، فإن أسئلة عميقة، مؤرقة، ظلت تتنامى في أدب خلف أحمد خلف الطفلي، على مستويي البنية والدلالة .
لقد رأينا كيف استجابت المسرحية لديه لقوانين الدراما، عبر خلق الصراع المتوتر، المتنامي، في تشكيلة متضافرة من الشخصيات والأحداث ، وكيف اهتمت بتجسيدات الفعل الدرامي ونموه، وصاغت المؤثرات الفنية المصاحبة، والكاشفة له، فالبنية الفنية المتوسعة، المتغلغلة في الحدث والشخصية، تحافظ على إيقاعها المكثف، وتضبط كل عناصرها.
وتكمن أساسيات البنية الفنية في خلق الثنائيات المتضادة مثل: الرجل – الطبل/ الرجل – الكتاب، الطائر/ السلطان، النحلة/ الأسد، وتنمو الثنائية المتضادة، عبر جزئيات مساعدة. تدخل في سياق الثنائي المتصارع، وتجعلها حيوية، متلونة، جذابة.
وإذا كانت هذه الثنائية قد غلب عليها التشتت في (العفريت)، فتأجل الصراع الدرامي إلى منتصف المسرحية، فإن الصراع يبرز بسرعة وشدة في (وطن الطائر)، عبر فكاهة موسعة، ولغة تحافظ على بساطتها وجمالها، ثم لا يكون سوى الصراع في النحلة والأسد. الذي يتوسع باتجاه جمهور الصالة.
وعلى مستوى الموضوع، فإن البنية تبتعد تدريجيا عن التجريد، حيث ان ثنائية الساحر/الصبي، أو الرجل – الطبل/ الرجل – الكتاب، تمثل موضوعاً ثقافياً مجرداً، يصلح للصبية الذين يبتعدون عن عوالم الطفولة، في حين أن ثنائية الطائر/ السلطان، تقترب أكثر من المحسوسية والبساطة، محتوية على إشعاع أوسع، ومع هذا، فإن موضوع ثنائية الحرية – الوطن، له صلة وثيقة بعوالم التجريد الفلسفي.
ويغدو موضوع ثنائية النحلة / الأسد، معبراً ببساطة ملموسة، عن قضايا واسعة، وفي قلبه تكمن كل الأسئلة المثارة في عوالم الكبار، لكن هنا تبقى الحكاية ذات الدلالات السياسية، في متناول ذهنية الطفل، وتعبر عن عالمه الخاص.
ولابد هنا من القول، أن هذا النمو، عبر تكثف البنية ودراميتها المتزايدة، يتضافر مع تركيز الموضوع، وتوسع الدلالة.
فمسرحية (العفريت) تحوى اكثر من موضوع محوري، فتتردد الموضوعات والدلالات بين محاور الرجل الطبل/ الرجل الكتاب، والصبي/ العفريت، وصلاح، فلا نعرف، هل المسرحية تتوجه للتعبير عن أهمية الكتاب، أم تتحدث عن ضرورة مساعدة الفقير، أم عن عدم جدوى السحر القديم؟.
في (وطن الطائر) يتركز الموضوع أكثر، ويظهر محور واحد فقط، تدور عليه الحبكة الدرامية، فيغدو نقد الاستبداد والتحكم في حنجرة الطائر/المبدع، أكثر بروزاً وسيطرة من محور الصخرة/ الحرية/ الوطن، بل ان هذين الجانبين يتداخلان معبرين عن حالة واحدة ذات وجهين. ان الثنائية الصراعية تبرز هنا ملغية الجوانب الهامشية، فتتجه البنية الفنية للتبلور.
وتغدو الدلالة أكثر وضوحاً وقوة واتصالاً بالجمهور – اطفال الصالة – حين يصير الموضوع موضوعاً واحداً، وتبدو ثنائية النحلة/ الاسد، مستولية حتى على العنوان، ويغدو التصوير متجهاً بقوة للتعبير عن (المستوى السياسي) للبنية الاجتماعية.
ان التصوير المغتني، يترافق مع تطور مواقف الشخصية (الايجابية – المحورية) في المسرحية. فإذا كان التصوير يتناول في (العفريت) المستوى المعرفي للواقع، مفصولاً عن الصراعات السياسية والفكرية، وإذا كانت الشخصية المحورية، في ذات المسرحية، الصبي (علاء الدين) الفقيرة، سلبية كذلك، مثل الشخصية الثانوية الغنية (صلاح) .
فان التصوير يتسع في (وطن الطائر) مستوعباً المستويين السياسي والفكري، ورغم سلبية المقاومة التي تبديها الشخصية المحورية (الطائر)، إلا أن هذه المقاومة تتسع عبر شخصيات إيجابية ثانوية كالراويين والحكيم. ليغدو التصوير سياسياً قوياً مباشراً في (النحلة والأسد)، ولتتركز القوة في الشخصية الإيجابية المحورية وهي النحلة، ولكن هذه الايجابية لا تتجه للبحث عن وطن اخر، والابتعاد عن المكان المحوري، بل لتغييره نفسه.
ولكن هذا التطور الواسع الذي رأيناه عند خلف أحمد خلف يصل إلى ذروته، وتظهر تناقضاته بوضوح.
لقد رأينا كيف أن مسرحية (النحلة والأسد) تمثل بنية درامية متبلورة وقوية، لكن في إطار التعميمات السياسية.
وكان يمكن للترميزات أن تغدو عميقة وواسعة الدلالة، عبر تنامي الحدث في جوانب جديدة وجريئة، لكن الحدث ظل مبسّطا. ففجأة قررت النحلة أن تقاوم الأسد وتقود الحيوانات في نضال حازم، سرعان ما تكلل بالنجاح، نظراً لغباء الأسد الشديد.
هذا التبسيط يقود إلى تسذيج الواقع الاجتماعي، وتوصيل هذا الواقع المسذج المبسط إلى الطفل. وكانت لدى المؤلف فرص عديدة لتعميق الحدث واغنائه بتفاصيل نفسية وحياتية، لكنه اتجه بسرعة إلى عرض الصراع وتسريعه وحسمه.
هنا تحولت الشخصيات إلى انماط، الى قوالب للفكرة ـ صوت المؤلف، فقد ظهرت النحلة قرية ذكية نبيلة، وظهر الأسد ضعيفا غبيا أحمق. وسرعان ما انتقلت الحيوانات من السلبية إلى الايجابية، ومن الخضوع الكلي للأسد إلى التحرر المطلق منه.
إن التنميط وسيطرة الفكرة العامة وإلغاء الخصوصية والتفرد، تبدو هنا واضحة. ولكن يمكن أن تكون هذه المشكلة، بداية لتطور خاص في مسرح الطفل البحريني.
ان خلف احمد خلف خريج الفلسفة، تسيطر عليه منذ البداية الأفكار العامة، لكنه يصارعها ويجسدها ويؤنسنها، عبر نقاط التحول التي رأيناها.
وهنا بلغت الفكرة العامة ذروة ما، اجتازت التفكك والتناقض المجرد، وتبلورت بوضوح، ولكنها وجدت نفسها عبر صراع عام، لم يغتن بسيرورات وعقد خاصة. فهل ستوامل هذا الطريق نفسه أم ستغتني بأشياء جديدة ؟.
إن إشكالية الأنماط والتعليمية والشخصية/ البوق، تطرح نفسها بقوة على أدب الطفل في البحرين. فقد كان إبراهيم بشمي يركز على توصيل الفكرة النقدية، بغض النظر عن المعلومات، وقراءة الألوان والحيوانات الحقيقية في الطبيعة، مهتماً بتجسيد الايدلوجي التعليمي، أكثر منه بتصوير العالم، وعرض النماذج، فكان خياله قريباً، ومشكلاته واضحة جدا وشخصياته انماطا لمشكلة أو فكرة، دون أن يكسر هذه القولبة، ويغني ويعمق هذه الشخصيات.
وفي حين حاول إبراهيم سند تضفير الحقيقي بالخيالي، وخلق تركيبة واقعية – فنتازيا، بسيطة وعميقة في آن، ذات دلالة تعليمية وجمالية تعبيرية خاصة’ فإنه لم يهتم كثيراً بتجسيد النموذج، هذه الشخصية الترميزية، التي يتضافر فيها العام والخاص، وتغدو حالة معروفة لدى الأطفال، مثل شخصيات ادب الاطفال الشهيرة.
لقد توقف عبدالقادر عقيل عن إنتاج قصة الطفل، وهو الذي كان يقوم بذلك التضفير نفسه بين الواقعي والفنتازيا، النقدي والخيالي، السياسي والسحري. وقد بدأ بشخصيته (ندى)، وبدت ندى نموذجاً صالحاً للتطور، ولكنها ظلت (قالبأ) يصب فيه المؤلف ارشاداته الاجتماعية المضيئة، عبر لغة شعرية جميلة. لقد توقفت ندى عن النمو.
لقد بدا كتاب البحرين ينطلقون من نسبة كبيرة من الخيال، لكنهم راحوا يتجهون نحو الواقعية – المباشرة، مقتربين من التوجيه التعليمي، عبر الاقنعة الحيوانية والنباتية المتعددة.
إن نسبة الخيال تتضاءل كلما ابتعدنا عن عبدالقادر عقيل وإبراهيم سند، وتبدو عملية رفض الخرافة وقصص الفنتازيا متنامية بقوة في النتاج الأخير من أدب الأطفال. وراحت بعض الميول التعليمية المبسطة تفرض نفسها على النتاج، وتقدم الفكرة الاجتماعية في (قالب) مبسط .
إن عدم ولوج أدب الأطفال إلى الحكايات الفنتازيا والخرافية وتطويعها، يعود ربما لهذه النظرة المتجهة إلى تسليط الأضواء على الحياة الواقعية المباشرة. وربما لعدم وجود القدرة الفنية على الممازجة بين الحكاية الخرافية والواقع المعاصر.
لكن لاشك أن الفنتازيا المغرقة، واستخدام الخرافة والقصص الشعبية إستخداما سيئا ومفزعا، هو محذور ينبغي تجنبه، لكن بعدم الوقوع في التبسيطية و التسطيح من جهة اخرى.
وطن الطائر: نموذج معبر لأدب الطفل في البحرين

في مسرحية (وطن الطائر)، يطور خلف احمد خلف التقنية الدرامية التي بدأ بتجسيدها في مسرحية (العفريت).
والفكرة الاساسية للمسرحية مأخوذة من قصة للأطفال، غير منشورة، كتبها الشاعر قاسم حداد (انظر الكتاب ص91). والقصة تصور طائراً جميلاً ذا صوت خلاب سجنه ملك، فيرفض الطائر التغريد، ويغريه الملك بطبيعة ساحرة لكنها مسورة، فيواصل الطائر الصمت، حتى يكاد ينفق، فيطلقه الملك ليعرف أي مكان هذا الذي يفضله الطائر على القصر وحديقته، فيجده يغرد فوق صخرة جرداء في المياه.
هذه هي الفكرة المحورية التي اقتبسها خلف، ليبدو شكل تجسدها على الخشبة، هو الاضافة الدرامية للفكرة.
والفكرة، كقصة للأطفال، بسيطة وشاعرية، لكن كيف يمكن أن تتحول إلى دراما غنية بالحركة، والتلون وتباين الشخصيات وصراعاتها؟.
إن بعض الثيمات التي استخدمها خلف في (العفريت)، يواصل استخدامها وتطويرها هنا.. فشخصية الراوي، المتحدث في الحكاية، المعلق عليها. تظهر هنا أيضاً، ولكن بصورة (طفل) و(طفلة)، مرحين، ساخرين من السلطان وقفصه وابنته البلهاء. وإذا كانت بعض مقاطع حضور هذا الراوي المشترك، ضمير المؤلف والأطفال معاً. حيوية، نابضة، فإن بعضها الآخر، زائد وتعليمي ومرهل لجسد المسرحية. كحديثهما الفكري عن الحكيم والحرية ص 122-123.
ان وجود الطفلين، الراوي الواحد المتسق عقلاً، المختلف جنساً، ضمير العمل، يطلق الحركة الدرامية عبر تعليقات ساخرة على السلطان وابنته وحرسه، أو عبر التعليقات الجادة على الحكيم، أو لوصف حركات وأحداث لم تظهر على الخشبة..
إن وجود هذا الراوي هو أول تجسيد درامي للقصة، وهو أول جر للقصة من ميدانها السردي المكثف، الى جسد المسرح الحركي الصراعي التجسيدي، وتنبيضها لوناً، لكن وجود الراوي الثنائي من جهة اخرى، وفي بضع مواقع، يوقف الحركة الدرامية ويثقلها، فيكون أشبه بوجود كاتب القصة في المسرح، أشبه بحضور السرد في الدراما.
وعلى سبيل المثال، اقرأ الفقرة الطويلة في ص 148، حيث يتناوب الطفلان – وهذا التناوب جزء من محاولة الخروج من مأزق الراوي الشارح – مدح الحكيم وحيلته في تحرير الطائر من أسر السلطان وإطلاقه إلى وطنه، إن هذه الفقرة، ليست سوى تمن بالذهاب مع القافلة ومدح الحكيم: (يا له من رجل حكيم – سأكون ابن الحكيم – سأكون ابنة الحكيم – وسنرى هذا الوطن الجميل.. الخ).
أن الأجزاء الخيرة من الصراع، كالطائر والحكيم والصخرة، توصف عن قبل الراوي المشترك بكل صفات الطهر والطيبة، في حين توصف الأجزاء الشريرة من الصراع كالسلطان وفهمان ونبهان والابنة والحراس، بكل صفات الغباء والقبح.
ومن هنا يكن المدح المبالغ فيه للجانب الخير من قبل الراوي، والسخرية الزائدة على الجانب الشرير، تحجيماً لوعى الطفل وتعليمية مباشر، حاول المؤلف أن يتجنبها.
ونجد الروح الدرامية لا تتجسد فحسب عبر وضع الراوي الممتع، وتعليقاته الذكية، بل عبر التنويع والإمتاع والتلون في شخص السلطان وحرس وابنته. ففي القصة القصيرة عند قاسم، لم يكن يوجد سوى الملك بمفرده، في مواجهة الطائر، لكن هنا يتحول السلطان إلى ما يشبه المهرج الخفيف الظل، لكن الباطش السطوة، القاسي.
إن صفات السلطان المتعددة تظهر، تباعاً، من خلال خطاب الراوي، وهو يبدو بحركاته الكثيرة الخرقاء، وطريقة فهمه للأشياء عبر الشكل العجيب، حيوي الظهور، مرح الكلام، لكن في إطار قسوة مستمرة، وصلف، هو جزء من تكوينه.
ويحيط الكاتب السلطان بثلة من البلاهة، تتجسد في شخصيتي الحارسين الاخرقين (فهمان)، و(نبهان)، الذين يغدوان كإضافة مهرج ثنائي، إلى مهرج مركزي هو السلطان، ويغدو استغلال غباء الحارسين، بدءاً من إسميهما الى حركاتهما وتصادمهما المستمر، وذكائهما الذي يتحول الى غباء، إضافة جانب ممتع ومسل وساخر إلى جانب السلطان.
إن الهالة التي تحيط بالطبقة الراقية تتمزق هنا عبر أنماط ملموسة.
ولا يكتفي الكاتب، بهذا التمزيق، لكن يضيف نمطا ثالثا مغايرا، جوانبه السلطان، التي كانت تغدو في الحكاية القديمة، رمزا لكل ما هو نقي وسحري وسري، فتصير هنا ابنة بلهاء مضحكة طيبة، تركب فوق ظهر أبيها وتحوله الى حمار، تستغل وجود نبهان وفهمان الآدمي بديلا عن دميها.
ان فكرة تحطيم الأوهام القديمة الفكرية – الفنية تستولي على مسرح خلف، عبر رفضه لفكرة الساحر القادر على كل شيء في (العفريت) وتمزيق ما هو مدرسي بليد، تحنطه الكتب، لنجد هنا ابنة السلطان تنزل من عليائها الى الواقع، ويرى الصغار اجنحة الحكايات الخيالية القديمة وهي تحترق فوق الارض، وتتكشف هذه الأنسجة المعقدة للثقافة والمجتمع، عبر مفردات الفن (البسيطة) المقدمة للأطفال.
ان حركات ابنة السلطان المتعددة تضيف بهجة وحيوية أخرى على النص القصصي، الذي سُحب الآن، من سكونه السردي الصراعي المكثف، إلى اتساع الشخصيات المتضادة والتعارضات البهيجة – المؤلمة، وتنوعات المواقف والأشياء..
ان القصة القصيرة ببنيتها المضغوطة وشخصيتها شبه الوحيدتين، تتباين مع بنية المسرحية ذات الاتساع غير المطول، والمتبلور في عملية صراع، متنامية، متعددة الوجوه، وإذا كانت القصة تقدم (الشرير) في شخصية، فإنها تقدم (الخير) في شخصية مقابلة، وهو الطائر، لكن في المسرحية تتسع الشخصيات المتقابلة، فكما تعددت وجوه السلطان والحاشية، فقد اتسعت شخصية الطائر لتصير راويين وحكيما يقدم المشورة الذكية الخبيثة ليسجن من قبل السلطان. أن الطائر الذي لا يتكلم في القصة، يفصح عن ذاته، ويتجسد مضمونه عبر شخصيات متعددة في المسرحية.
ولا يكتفي الكاتب بإضفاء توترات درامية – هزلية على المسرحية، بل يستفيد من التقنية المسرحية الصرفة، عبر كتابة ارشاداته عن الديكور والحركة، الأمر الذي يغدو اخراجا اوليا يتواصل عبر نص المسرحية. انه يقسم المسرحية ست لوحات، هي مقاطع المشاهد المتتالية النامية عبر عرض المسرحية، ويكتفي باستخدام [الديكور الرمزي في اللوحات الخمس الأولى] ص 90، حيث أن أجواء المشاهد تتحد في عوالم القصر والحديقة، وهذه أمكنة مسرحة يمكن التحكم فيها، من قبله. لكن اللوحة السادسة [تحتاج إلى تجسيمات عديدة لتقريب وتصوير مغزى المسرحية حول ارتباط الحرية بالوطن.. يمكن الإكثار من المؤثرات البصرية والسمعية في تلك اللوحة].
ان اللوحة السادسة هي لوحة قصصية، وتمثل لحظة الانتقال الحركي الطويل للسلطان والحاشية الى صخرة الطائر البعيدة، وطيران هـذا الطائر اليها، أيضا، مما يجعل التجسيد المسرحي صعبا.
ان اهتمام المؤلف بـ(المغزى) وضرورة تجسيده بالمؤثرات تدل على الرغبة الدقيقة في تحديد نمو المسرحية بالكيفية التي يراها، فهو يخرج المسرحية قبل إخراجها.
وتتضح العملية الاخراجية من سيطرة الكاتب الدقيقة على حركة الشخصيات، وأشكالها وملابسها، وقطع الديكور والمؤثرات. وكمثال نقرأ ما يلي: [الطفل: (يدخل على أطراف أصابعه محاذرا اصدار صوت، يتلفت في حذر تجاه الرجل النائم] و[فهمان ونبهان: يسرعان في التحرك فيتصادمان ويقعان على الارض، يسرع السلطان باتجاههما فينهضان بسرعة ويخرجان صارخين] الخ..
وهناك امثلة كثيرة على التحديد الدقيق لحركة المسرحية، واغلب هذه الإرشادات الإخراجية تستهدف تحديد عملية المسرحية للنص الأدبي. وهذه الإرشادات تدفع باستمرار باتجاه تنبيض اللغة وتجسيدها، واثارة المفارقات الجسدية، الحركية، اللونية، الشخصية، وإبعاد المسرحية عن الطابع التأملي العقلي. والكاتب يفلح في استنطاق النص قبل اخراجه، عبر عشرات الإرشادات التي تبدو عفوية في الصياغة، ومن هنا كانت عروض مسرحياته هي أعمال تنفيذية تنساق وراء الإخراج الضمني فيها.
ويجب أن نتوقف هنا حول (المغزى).
ان الكاتب لا يوضح فقط طريقة نمو التسلسل الدرامي وتجسيداته، بل يصر على المغزى وتحديده، فيقول [.. لتقريب وتصوير مغزى المسرحية حول ارتباط الحرية بالوطن ].
ان جملة الارتباط هذه تبدو غير واضحة، فالحرية مفهوم سياسي واجتماعي خاص، والوطن كيان ملموس، وليس ثمة علاقة مشتركة محسوسة. فهل يزول الوطن عندما يكون مستعبدا؟ أو يظهر الوطن فقط في الحرية؟ وهل يفر الإنسان / الطائر من وطنه إذا كان مكبلا؟ أو أن المواطنة الحقيقية لا تأتي إلا في وطن حر؟
ان المسرحية تهدف الى القول، ببساطة فلسفية، ان الوطن يكمن حيث توجد الحرية. ولكن ألا يقلل هذا من الوطن، ومن الحرية معا؟
واذا جئنا إلى القصة القصيرة، أساس النمو الدرامي، فإن (مغزى) آخر يتبدى هناك، حيث الطائر هو المبدع، الذي لا يستطيع الإبداع – الغناء وهو ملك لأحد. ان الابداع تمازج والحرية ، ويذوبان في سيرورة واحدة.
وتغدو الصخرة الصغيرة في البحر، المجردة من القضبان، هي موقع التغريد والفعل الحر والوطن. ان سياقات القصة الداخلية أكثر عبر هذه الترابطات الوثيقة.
ولكن كان من الصعب ـ على ما يبدو ـ إبراز هذا -المغرى- في مسرحية تقدم للصغار، فكان لابد من التحوير، وتغيير طابع المسرحية، لتغدو الصخرة هي الوطن وهي الحرية، وأن الطائر لا يستطيع أن يحيا (لا ان يغرد فحسب) إلا في وطنه، الذي هو الحرية.
لقد اقتضت طبيعة النوع الأدبي الخاص. وهو مسرح الطفل، تغيير الموضوع، لكنه تحول الى موضوع تجريدي. فنشأ تناقض بين الموضوع وطبيعة النوع الفني، الأمر الذي أدى في الصياغة الى محاولة التغلب المستمر على الطابع التجريدي، بجعله ملموسا، حيا، قريبا، وهذا أغنى تطور بعض الأدوات الفنية، من جانب، وظهور بعض المباشرة، من جانب آخر. لكن (المغزى) ظل مع هذا مراوغا، كقول الطفلة متحدثة عن السلطان [لا يقتنع ابدا ان غناء الطائر هو الحرية.. وليس الحديقة السجن التي أقامها] ص 121، أو قول الطفل [ نعم.. نعم.. الحرية التي غنى لها هذا الطائر اجمل اغنية] ص 123. بعدئذ تصبح الصخرة وسط الماء هي الوطن، الحرية.
وتقيم المسرحية سلسلة من التضادات المطلقة، فهناك: الطائر، الحكيم، الراويان، الصخرة، الغناء، الوطن، الحرية، السعادة، الجمال، الذكاء.. الخ.. في جهة، ومن جهة أخرى هناك السلطان، القصر، السجن، الابنة، فهمان ونبهان، الحراس، الغباء، القبح .. الخ.
ولا يحدث الانتقال من جانب إلى اخر، في الشخصية، ويظل الخطان متضادين، وحين تنتقل الابنة المعتوهة إلى وطن الطائر والخط الآخر، فإنها تفعل ذلك بصورة غير مقنعة فنيا.
ان وجود هذه التضادات في العالم الفني، يجعل الشخصيات منمطة، فالحكيم رمز الحكمة والكفاح، والطائر رمز الحرية، وهكذا بقية شخصيات الخط الأول، يغدو السلطان رمز المحدودية والضحالة، الخ..
ان الية النمطية تتيح توصيل التوجيه والمباشرة، لكنها تجعل العالم الفني أكثر احتياجا للغنى والتعدد.
January 10, 2024
ابن باجة* : كتب ــ عبدالله خليفة
ابن باجة* : كتب ــ عبدالله خليفة
ابن باجة* : كتب ــ عبدالله خليفة
ابن باجة* : كتب ــ عبدالله خليفة



