عبـــــــدالله خلــــــــيفة's Blog: https://isaalbuflasablog.wordpress.com , page 26
November 14, 2023
عدم الإيمان والعقلانية
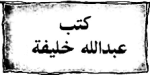
يتمثل الإيمان الديني الإسلامي أساساً بالإيمان بقوى الأغلبية من المسلمين العاملين لنهضة حياتهم ولتقدم الأمم الإسلامية.
وكان الإيمانُ توحيداً، على مستوى الألوهة ومستوى البناء السياسي.
وقد قامت القوى المحافظة بتمزيق وحدة صفوف المسلمين، فيما هي ترفعُ لواءَ الإيمان الذي لا تؤمنُ به.
إن كلَ أمةٍ وكلَ مجموعة من الأمم لها نسيجها من الوعي الديني، وتنمو إراداتها السياسية التحديثية داخل هذا النسيج، وبطبيعةِ الحال هناك خيارُ الألحاد، وهو خيارٌ مستقبلي إلغائي للحاضر وللأمكانيات العقلانية التدريجية فيه.
حين يلغي السياسي وربما كان باحثاً وقائداً كبيراً الإيمانَ الديني، فإنه يحلُ ذاته المتضخمة محل الذات الإلهية، سواءَ كانت وجوداً محضاً كما يؤمنُ المؤمنون بها، أم كانت رمزاً تاريخياً لهذه الأمة أو تلك.
ومن هنا رأينا كيف أن العلمانيين والملحدين الأروبيين في نشرهم لمختلف صنوف وعيهم من علوم ومن نظريات، كانت أغلبيتهم تركز على نقد مرجعيات رجال الدين المحافظين، وتدعو لأسس نهضوية جديدة لحياة الأغلبية الشعبية وهي مصدر الإيمان. فكان إنتصارهم وتقدم أفكارهم.
فأي فكر ديني أو إلحادي أو علماني لا يعمل لتطوير حياة الأغلبية الشعبية من العاملين، يتم نفيه من حركة التاريخ، ومن هنا كان الإسلامُ المؤسس هو القائد في تغيير حياة الجمهور الشعبي المتخلف الذي كان يعيشُ في مؤخرة العالم!
وكانت الدول التي جاءت بعده يعتمد وجودها أو تفتتها على مدى حفاظها على ذلك المبدأ.
وهذا من حيث حركة التاريخ العامة، فماذا عن خيار الألحاد؟ إنه لا يختلف عن ذات الخيار الديني، لكنه كنظام يسقط كذلك، فمن حيث حركة التاريخ العامة ينطبق عليه ما سبق، فإذا كان متوجهاً للحفاظ على مصالح الأغلبية من العاملين والمنتجين فإنه مع حركة التاريخ التقدمية، وإذا انحرف وأغدق على الفئات البيروقراطية والعسكرية الحاكمة المتنفذة، فإنه يسقط مثل الأنظمة الأخرى.
حين يتضخم القائد للنظام الديني أو الألحادي أو العلماني أو القومي ويحتكر المنافع لذويه وحزبه، فإن حركة التاريخ تلفظه، وهي تجعله داخلها فقط لأنه قادر على السيطرة المرحلية إلى حين، وحين تتوقف الموارد التي يعتمد عليها تحدث عملية الحراكِ المدمرة، أي التي لم تخضع لضبط اجتماعي عقلاني من قبل الجماهير.
حين يلغي القائدُ الإلحادي المؤسسات الدينية المستقلة والأحزابَ المعارضة له فإنه يريد أن يحلَ محلَ الإرادة الإلهية، بالضبط كما يفعل الحكام الدينيون الفاسدون السابقون، فأختلف الشكل.
وإلغاء الدين هي عملية لرفض التطور الديمقراطي الطويل لأغلبية العاملين، مثلما يكون إحتكاره من قبل بعض رجال الدين المحافظين، أو من بعض المذاهب التي تدعي أنها الوحيدة القادرة على فهم الدين!
وفيما أن القائد الشيوعي يقول بأنه يستند على العلوم الحديثة، يقول الزعيمُ الديني المتنفذ إنه يعتمد على العلوم الشرعية، وكلاهما يعتمد على البطش، وسواء جاء عبر دولة بمؤسسات قمعية حديثة أو عبر مليشيا شعبية مغسولة الوعي.
الألحاد والإيمان الديني المغلق كلاهما إنكار للتطور المتدرج لأكثرية المسلمين، فالملحد العدمي كف عن القراءة ومتابعة تطور أمته، ورؤية سبل تطورها العقلانية المتدرجة والكفاح داخل هذه السبل، وأحل ذاته الشمولية التي تصدر الأوامر من عليائها.
مثله مثل القائد الديني المحافظ المغلق أحل ذاته بذات السبيل، وجعل فكرته الدينية مصدراً للحكم، فعلى الأمة أن تتبع فكرته، وليس أن فكرته تعبر عن مشاكل الناس وتناقضاتهم وتنوعهم وتعدد سبل تطورهم وأن يرهف أسماعه وأبصاره للتحولات المعقدة في حياة أمته لكي لا يجعلها تذوب وتمسخ بل أن تقاوم وتتحدث!
كل من الملحد والديني المغلق والعلماني المستورد يريد الأمة أن تمشي على برنامجه المعد سلفاً، بسبب محدودية بيروقراطيته الحزبية ولجنة جماعته القائدة، والتي يتوهم إنها عرفت التاريخ كله.
وفيما أن الملحد يلغي تراث أمته، فإن الديني المغلق يجمد هذا التراث، وفي كلا الحالتين فإن التراثَ معطل، مرة بسبب رفضه، ومرة بسبب إلغاء تطوره وتاريخيته، ولكن التراث المحافظ موجود ويتحكم في حياة الناس، ويحدد زواجهم وطلاقهم وإرثهم وكيفية موتهم وعلاقاتهم وحكمهم وعقودهم الخ..
والألغاء لا يشل حضوره، والتجميد يزيد من مشاكله، ويقلل من إشعاعه، وبين العدمية والحفظ في الثلج، يعتمد وعي الأمة على العقلانيين الذين يدركون إستحالة الألغاء والتجميد معاً، ويبحثون عن سبل التغيير الممكن، حفاظاً على الإرث وذواب الأمة في الفراغ، وتطويراً لحياة الناس، بما يحقق التقدم والمعيشة الجيدة لأغلبية المنتجين.
November 13, 2023
انتظر (بحماس) صواريخ إيران على إسرائيل
مثل أي مواطن عربي ومسلم ساذج وغبي انتظر صواريخ إيران على إسرائيل.
انتظر بحرقة وشوق وحماسة شديدة وعتيدة هذه الصواريخ المنقذة لشعبنا في غزة، الذي يحترق بالمجازر الإسرائيلية بكل صنوف القتل المتعمد.
سوف تأتي حتماً هذه الصواريخ حتماً وتزول إسرائيل.
لقد اعترف رؤساء وملوك العديد من الدول العربية بأنهم لا يستطيعون التورط في حرب مع إسرائيل، قالوها وأيدوا عمليات السلام المختلفة، وساعدوا منظمة التحرير الفلسطينية بما يستطيعون وآزروا السلطة الفلسطينية بما يقدرون عليه.
من أجل أن تنهض هذه السلطة الفلسطينية وتتقوى ويكون لها في الزمان القادم وهي على الأرض فعل جديد، لا أن ترضى بالاحتلال والهمجية الصهيونية.
منطق بعيد المدى، تعلم من دروس الماضي، وختم على المراهقة السياسية والعنتريات التي لعبت أدوارها المشبوهة في ضرب نضالنا القومي.
لكن هذا هو منطق المتعلم المثقف العربي لكنني حماسي وانتظر الحل السريع الباتر.
وقد أعجبت كثيراً بتصريحات بعض القوى السياسية التي نددت بمواقف الدول العربية، وبأنها مواقف جبانة وتكتفي بدعوات لاجتماعات وبانقاذ للمصابين من الحوادث وأنها مجرد بيانات، فقلت سوف يأتي الرد القوي من العاصمة التي يدينون لها بالولاء والتي تدفع رواتبهم ومكآفاتهم النضالية، وتعقد اجتماعاتهم القومية والإسلامية والعالمية، خاصة وقد تفجرت من بيروت تنديدات بالقيادات العربية وأنها متواطئة مع العدوان، رغم أنها شاحبة ومحدودة، على عكس صخب بيروت المعتاد.
قلتُ: سيأتي الرد من طهران.
سوف تتفجر الأرض من تحت أرجل وجنازير الطغاة المحتلين المجرمين.
سوف يأتي الرد من طهران انتظروا.
كيف لا؟ وقد تركت “حماس” صفوف الدول العربية والتحقت بقيادة طهران، ولا شك أنها رتبت معركة دقيقة مع عاصمة النضال الإسلامي، بعد أن شقت منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية واندفعت في بطولة متفردة شجاعة فهي لا تمتلك حتى طائرة عمودية واحدة، ولا أسطولا، ولا شبكات دفاع جوي، ولا مضادات أرضية، وفي مواجهة أكبر جيش في المنطقة.
قلت: ليس هو انتحار كما يظن الساذجون بل مقاومة بطولية وطنية صغيرة ووراءها قوة عظمى كاسحة.
لكن العمليات الرهيبة الدموية الاجرامية استمرت من دون أن تظهرَ القوى الـمُنتظرة، فقد اعتدنا مظاهرات وصرخات الاطفال والفتيان والنسوان العربيات، لكن الرد القوي الجبار قادم من الرجال الصناديد في إيران.
لقد رحل خالد مشعل إلى هناك وأقام معسكرا رياضيا صاروخيا.
وقد نددت القوى المؤيدة للحلف المقدس الثوري بمواقف الدول العربية المتخاذلة وقلنا: سوف يقلبون الدنيا رأساً على عقب، لكنهم اكتفوا كذلك ببيانات، وتحركت فصائل الجمل الثورية في كل مكان، وحرقت الأرض بالأقوال الصارخة الباطشة بإسرائيل المجرمة.
بدأنا نفكر بجدية في خاتمة المطاف:
الرئيس الإيراني يعقد مؤتمرا صحفيا يدلي فيه ببيانات فلسفية عن طبيعة العدوان الإسرائيلي.
الجماعات الثورية جداً تعقد مظاهرات صغيرة والشعوب العربية خارج التاريخ الفعلي.
الدول التي اتهموها بالجعجعة هي التي نصحت “حماس” كثيراً بعدم سلوك طريق المراهقة السياسية، وأنها لابد أن تعود إلى طريق النضال الحصيف بدلاً من أن تعرض شعبها للخراب، من دون أن يصغي قادتها لذلك، ثم سكتت عن اتهامات هذه الحركة نفسها لهذه الدول العربية الشقيقة لها بالعمالة والتواطؤ لصالح إسرائيل.
خـُدعنا كما خـُدع غيرنا بصرخات الرئيس الإيراني وبأنه قادر على إزالة إسرائيل وربما سبحت حماس بحماستها الكثيفة في دخان هذا الحشيش الثوري، لكن الضحايا يبقون هم الضحايا، والجثث هي ذات الجثث التي تموت بأجندة المراهقين المغامرين.
هم أهلنا يذبحون أمام أعيننا بسبب هذه الجمل وهذه السياسات الرثة.
اكتفى قادة إيران بكلمات بسيطة مثل سنرميهم في البحر، أو نذيقهم ملوحته، تعبيراً عن البأس في القتال، فما أظهروا بأساً.
ولكن كلمات الرئيس السابق قوية (سوف نزيل إسرائيل)، (سوف نلغي إسرائيل)، (إسرائيل ليس لها مكان في الشرق الأوسط)، وخالد مشعل كان يرقص طرباً في طهران، وسكرت حماس على رغوة هذه الجمل وجرّت قسماً كبيراً من شعبها لمذبحة وأي مذبحة!
هم دائماً يفعلون بشعوبنا وبأنفسهم ذلك ويدعون الحصافة والعبقرية في النضال.
كم مرة جربنا ذلك ولم نتعظ ولم نأخذ دروساً؟
كم مرة نـُلدغ من الجحر نفسه ولا نتعظ!
سوينا بالحجر في لبنان ولم نتعظ وزايدنا وادعينا الانتصارات.
والآن سوينا بالأرض في غزة ولانزال نكابر.
متى لهذا الجمهور العربي أن يفهم؟
لا للاحتلال ولا للغزو الإسرائيلي الاجرامي ولا للحماقة السياسية العربية ولا لصواريخ إيران الوهمية ولجماعات المراهقة والتخبط السياسي كذلك.
30 ديسمبر 2008
November 11, 2023
قراءة في تقاسيم ضاحي بن وليد الجديدة
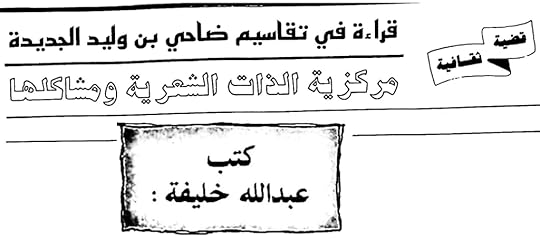
مركزية الذات الشعرية ومشاكلها
جاءت قصيدة علي الشرقاوي «تقاسيم ضاحي بن وليد الجديدة». بعد فترة من قصيدة محمود درويش «أحمد الزعتر». وهناك شيء من التأثير تركته القصيدة الاولى على قصيدة الشرقاوي اللاحقة، من حيث وجود شخصية محورية تعبر عن تجربة شعب ، أو تجربة أمة ، ومن حيث قيام الشخصية المحورية بفعل ايجابي . داخل بناء القصيدة الدرامي ، كانعكاس لفاعلية اجتماعية – شخصية متصاعدة، عبرت الشخصية – النموذج ، عن مضمونها الأساسي .
وإذا كان محمود درويش ينسحب «تماماً» من حدث القصيدة، تاركا الشخصية تنمو من خلال حوارها الذاتي المتقطع ، المتصاعد، فإن الشرقاوي لا ينسحب من القصيدة ، بل يشارك الشخصية الاخرى ، نشاطها ، بل ان شخصيته هي الشخصية المركزية في القصيدة، وصوته هو الاقوى ، وما المغني ، او شخصية ضاحي بن وليد الا لحظة من لحظات تجلي الشخصية المركزية ، التي هي ذات الشاعر.
فلم تكن شخصية ، ضاحي بن وليد ، تحتمل كل هذه المعرفة الأيدلوجية – السياسية الواسعة التي حملها إياها الشاعر، في حين كانت شخصية محمود درويش شخصية مبتدعة ، فأتاح ذلك إمكانية بنائها، وتطويرها في كافة الجهات، عبر بلورتها للتجربة الفلسطينية . لكن شخصية ضاحي كانت شخصية موسيقية وجدت فعلاً ، وعبرت عن مستوى معين من النشاط وارتبطت بمحدودية الفترة والواقع حينذاك، في حين كانت تجربة أحمد الزعتر متسعة متروكة لكافة الاحتمالات .
من هنا فإن شخصية ضاحي لم تستطع أن تحمل زخم تجربة الشاعر ، وقد بقيت ، من خلال القصيدة ذاتها ، في الحدود التي ظهرت فيها ، في الحياة ، فلم يقم الشاعر باعادة خلق لها ، او توسيعها ، ومن هنا اندفع صوته لاستكمال عملية توسيع التجربة المتنامية في القصيدة ، فغدت حياة ضاحي مجرد محطة لصوت الشاعر ، وليس شخصية كذلك . والفارق كبير هنا بين الصوت والشخصية . فالصوت هو بوح بالرؤية والفكرة ، في حين تظل التجربة الشخصية والملامح النفسية والتفاصيل الحياتية ، منفية من التجسيد الفني . فشخصية ضاحي تبقى في حدود صوته ، أي في حدود الفكرة ، التي استبدلها الشاعر بفكرته، بينما تغيب تجربة ضاحي الشخصية وممارستها اليومية الحميمة .
وهذا ، كما سنرى، يتوافق مع رؤية القصيدة وخطها الفكري . فالقصيدة لا تطرح سوى العام ، وليس الخاص ، تحاور المستوى الاجتماعي – السياسي المجرد ، لكن لا تدخل في تفاصيل الحياة اليومية والتجارب الذاتية ، فلا تمزج بين العام والخاص ، ولو فعلت ذلك لرأينا ضاحي بن وليد حقاً ، أي انسلخت شخصيته من شخصية الشاعر المسيطرة ، وغدت ذات خصوصية مستقلة . ولكن الشاعر الحقها به ، غدت صدى لنفسه ، ولقد اعطاها جوانب معينة هامة ، وهي الغناء والمعاناة ولكن لم نجدها تنمو ، في سياقها المختلف، لتتشكل في تجربتها المميزة .
في حين كان محمود درويش أكثر موضوعية بإعطاء الشخصية المحورية إمكانيات نموها الخاص ، عبر تجربتها..
(« نازلاً من نحلة الجرح، إلى تضاريس البلاد، وكانت السنة انفصال البحر»، «عن مدن الرماد»).
وتبدأ قصيدة الشرفاوي بهذين البيتين :
(منغمر في عسل التعب الطالع من حمى النحلة
منهمر في نسخ المحار الداخل احلام النخلة) .
واذا كان ثمة تشابه عبر تكرار «النحلة» في كلا المقطعين فإنهما ينموان بشكل مختلف، فالمقطع الدرويشي لا يعلن شيئاً عن الحالة الموصوفة ، انه فقط يفرش المسرح ، معيناً الظرف العام، تاركاً «البطل» التفاعلاته الخصبة مع الواقع .
لكن الشرقاوي يفتتح القصيدة بتحديد العالم الذي تدخله الشخصية والشخصية نفسها . فصوت ضاحي – الشاعر يؤكد انه منهمك في مصهر العمل القاسي في حقلي البحر والزرع ، أي في الأرض المقسمة عبر الانتاجين البحري والزراعي فالذات مغمورة بتعب الحياة الملتهب كحمى النحلة ، وهي صاعدة، عبر هذا العناء ، نحو الاحلام البعيدة المترامية في الحقول . أنها في كلا قطاعي الأرض صاعدة ، متألمة، منتعشة، متجهة إلى حلم التغيير ان صوت الشخصية يتوحد منذ البدء بالأرض ، بالإنتاج ، بالتغيير .
وهو يعيد إنتاج هذه اللازمة وتوسيعها في كل بناء القصيدة التالي . فما نمو القصيدة ألا شرح لهذا المعنى الذى كمن منذ البداية .
فتجد ان المقطع السابق يستدعي على الفور : الأرض . فهي تأتي مباشرة بعد المقطع السابق ليبدأ التداعي :
«والرملة» «هذى الألف المقصورة واقفة» في البحر كأن الفجر يحدق في تكوين الطير».
ان المقطع السابق الذى يوحي بالارض، يستدعيها فوراً على شكل خارطة ، فكأنها فجر يحدق في الطير . ويمكن عبر قراءتنا لعدة مقاطع اخرى بان نستنتج طابع القصيدة ونموها المتكرر.
وليست العلاقة في القصيدة إلا علاقة صراع بين الأنا الشعرية ، وصوت الشاعر ، والواقع الخارجي . إن هذا الصراع هو الصراع الأساسي المحوري. وما ضاحي بن وليد ، الا لحظة من لحظات تجلي هذه الأنا الشعرية، التي سرعان ما تتجاوز صوت ضاحي الخاص ، وما موسيقاه ، أو شظاياها ، الا جزء آخر من هذه الذات الشعرية ، التي تنمو وتنساب في كل الجهات وستغدو مدعوة لإحياء المشنوقين والمتلاشين ، فهي الصوت المكثف لإخراج العرب من ظلماتهم وهي الباعثة لحيواتهم الميتة … في مواجهة الفعل التدميري للغرب ، الذي سيؤخذ ، كجوهر آخر ، معاد ومرفوض ، كلية .
ان المقاطع الأولى التي تبدأ بها اللوحة تتكيء بقوة على صوت المغنى القديم، فصوت الأنا الشعرية يتوغل في ذاته ، يبحث عن لحظة الصعود الدرامية، فتمتلئ المقاطع بكلمة . «احاول»:
«احاول عتق الغبن المرهق في الشفتين» ، «احاول ان اجتاز بمهماز الوجد تخوم المابين».
(«واحاول» ، «مجروح وقتي» ، «من فض بكارة صوتي البدوي واعطاها السفلس ؟؟» ، «من لوث بالآلات الغربية موال النرجس» ، «من عقلني ؟»).
إن هذه المحاولات الدائبة للخروج تصطدم بالوقت بالواقع . وتغدو القصيدة تجربة ابداعية تحاول أن تتغلغل في هذا الواقع . وسيكون هذا الواقع واحداً ، حتى لو امتد الى الماضي ، عند بداية القرن ، في زمن ضاحي المغنى ، أو جاء الى الوقت الراهن ، زمن العقد الثامن، حتى لو امتد الى المغرب او عاد الى المشرق ، تجلى في الاغنية القديمة ، أو القصيدة المعاصرة ، انه واقع واحد ثابت ، عام ..
وهذا الواقع هو واقع الغاء الصوت البدوي ، او العربي ، او الشرقي أو «النحن». لهذا هو ليس واقعاً عربياً ، انه واقع غربي ، اجنبي . لأنه ليس بدوياً ، ليس عربياً صميماً . لا يستخدم العود، الآلة العربية الموسيقية ، الاصلية ، بل يستخدم الآلات الغربية . فصار العرب ، حسب هذه الرؤية ، اسرى واقع لا يصنعونه .
كيف إذن سيتشكل الصراع بين الأنا الشعرية والواقع العربي ؟ كيف ستقوم باستعادته ، هي الحرة وهو المستعبد ، هي البدوية وهو الغربي ، هي الانتماء وهو الاستسلام ، هي الاصالة وهو الزيف ؟!
انها تتراجع الى ذاتها. الى تعدد تجليات هذه الذات في حوارها الداخلي ، فيعود صوت الشاعر – المغنى ليحفر في نفسه ، سوف يسترجع اشكال مقاومتها ، حيث كانت الكلمة وسيلة لصعود المقاومة الداخلية ، والانغام البدوية صورة من صور الرعد الخالقة .
أن التغييرات الحاسمة لا تحدث الا في كون الأنا الداخلي ، بينما نرى الواقع الخارجي ، الواقع العربي ، كهفاً واسعاً بلا تغيير:
(«كهف في المشرق» ، «كهف في المغرب» ، «كهف» «ما اضيعه الزمن العربي على النغم الانثى» ، «ما اكثر ادوات النفي !!).
إن هذا الواقع العربي . الممتد من بداية القرن ، الى الآن ، وهذا الجسد العربي الكبير المتواصل المتقطع بين المحيط والخليج ، هو مجرد كهف ، انه الظلمة ، واللا حركة ، بينما يكمن النور في الأنا الشعرية ، فهي الحركة والفعل، وهي التي سنجدها تشتعل بالتغيرات والفاعلية والعطاء .
انها تبحث ، وتدور ، قد تتخثر احياناً ، قد تتمزق ، قد تموت مع الموت ، لكنها تعود للحياة، فهي الحياة ! أن المغنى يعود للحضور، والشاعر يتجسد باستمرار ، ليس في تضاريسهما اليومية ، ليس في فعلهما الحقيقي ، مثل احمد الزعتر وهو يتقلب في العربات المشتعلة بالغربة وفي الزنازن الشقيقة ويولد في معارك المخيمات، بل هما ، أو قل هي الانا الشعرية بؤرة القصيدة وسيدتها المطلقة، في نضالها الثقافي المجرد ، حين تستخدم الريشة لصياغة الكلام الممنوع ، وحين تنشىء طريقاً من بين الظلمات ، يكسر حد الجوع » .
انها الريشة ، أو الكلمة ، وهي تفعل وتخلق. «اراجيحاً للعيد» ، و«زغاريد الاعراس » و«تحول .. قداس الفرحة رمزاً» ، و«تكشف» ، «عمق اللغز» ،.. (ص 191 من كتاب قراءة نقدية في قصيدة حياة للدكتور علوي الهاشمي).
إن الأنا الشعرية بتجلياتها، عبر ضاحي ، عبر الريشة ، أو عبر القصيدة ، تقوم ضمناً باعادة النور والحياة الى الجسد العربي الميت ، تبعثه ، تحييه ، لا بالتوغل بين جموعه وتضاريسه ، تستكشفها، وتقودها في مسارات الأرض، كما فعل أحمد الزعتر ، الذي ظهر كأحمد الشعبي واليومي ، متشكلاً بين الناس ، ومفجراً لطاقاتهم معاً .. لا ، ليس مثل ذلك ، بل عبر نفثها هي للحياة في الجسد العربي الميت – الكهف . انها مصدر الضوء والطاقة والخلق !
إن الوعي الثقافي ، كما تتصور الأنا ، هو أساس خلق العرب وإعادة تكوينهم ، أو بعثهم ، وهو وعي تنفثه الذات، من مصدرها العلوي، ومن هنا فهي ليست بحاجة للدخول الى تفاصيل حيواتهم وعوالمهم المختلفة ، فيكفي انها تراه هكذا ، كهفاً واسعاً ، حتى يكون فعلاً كما تري ..
إذن لا يبقى لهذا الوعي الثقافي النخبوي ، الا ان يلغي الثقافة الغربية ، لكي يبرأ الجسم العربي من العلل والظلام ..
«مبحوح قلبي»، «فحيح الآلات الغربية»، «تحت السقف الديناري المغزول من الآهات على الوتر الصامت علبني»، «من شيأ صوتك يا عود النار ؟) .
فالمواجهة ستجري بين العود والآلات الغربية، بين الثقافة العربية والثقافة الغربية ، بين الشرق والغرب ، بين النحن والآخر، بين عالمين متناقضين لا يلتقيان ورغم أن الثقافة الموسيقية العربية تفاعلت مع الثقافة الموسيقية الغربية واغتنت بها كما اغتنت كافة أشكال الوعي العربي ، إلا أن الأنا الشعرية ، لا ترى ذلك ، وترى التقابل المطلق والتنافر الأبدي بين الشرق والغرب ، بين العود والآلات الغربية !
وتستمر آلية الصراع هذه في العديد من المقاطع التالية ، تعيد تكرار الرؤية ، كهذا المقطع :
(«العود الهجس»، «مثل المخطوطة»، «من يكتشف النغم الانثى»، هذا المغمور كعرق النور بخارطة الحزن العربي»)، ص 193.
فالعود ، كالمخطوطة ، تجليان للثقافة العربية، وهما أساس خلق الفعل للجسد ، هما مولدا النور في خارطة الظلمة العربية . هما اللذان يشكلان الخصب للجسد ، هما الفعل الذكوري (مع مجيء الريشة) لصناعة المولود العربي .
ويوضح ذلك ايضاً بعدها (هل غير العازف في الظلمات هناك نبي ؟) فالظلمات المتكاثفة في الكهف العربي ، لا تزيحها إلا الثقافة العربية النخبوية: صناعة المثقفين المتميزين ، صناعة الأنبياء . وهنا ينفتح باب الثقافة الصوفية المثالية ، بعد أن فقدت القصيدة طريقها في العثور على الحقيقي بين المبدع والناس ، بين الطليعة والشعب . أو قل بان تصور الثقافة باعتبارها صانعة التاريخ بشكل مطلق ، وبان المبدع هو خالق الجسد العربي الجديد ، قد فتح الأبواب ليتحول هذا المبدع الى وعى مقطوع الجذور بالواقع ، ليأتيه الوعي من الخارج ، من السماء ..
November 9, 2023
الدكتور إبراهيم غلوم .. ورؤية خاصة وغريبة عن التجريب المسرحي
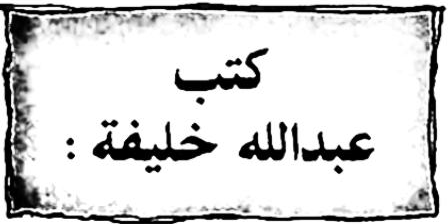
للدكتور إبراهيم غلوم مساهمات هامة في الدراسات الأدبية والنقدية والمسرح، واتجاهه لتطويرهما واكتشاف ملامحها الداخلية البعيدة. وأعماله تعتبر منعطفا في سياق دراسة الأدب في الخليج وربطه بالمناهج الحديثة.
لكنه في اتجاهه لخلق اتجاه تنظيري تجريبي في المسرح؛ يبتعد كثيراً عن تلك المنطلقات، بل وحتى عن تجربته المسرحية الوحيدة.
وقد قدم ورقة لرؤيته التنظيرية لهذا المسرح التجريبي في محافل عدة، كان آخرها ندوة أجريت عن المسرح التجريبي في البحرين. وسبق للورقة أن نشرت في جريدة الأيام. كما أنها مطبوعة بشكل خاص لدى مسرح أوال.
يبدأ د.ابراهيم غلوم ورقته «إرث مشترك، حلم جامح: عن التجريب وتداخل الثقافات»؛ بالدعوة الى ممارسة جهد عقلاني منفتح، وتقفز هذه الجملة العقلانية فوق السطور؛ بشكل دائب، داعية دوماً الى الاكتشاف والاستبصار والتفتح العقلي. غير أننا لا نعرف ما هي هذه العقلانية؛ التي تتضاءل باستمرار تحت اندفاع اللاعقلانية.
اللاعقلانية، هذه، تظهر بشكل خجول، وما تلبث ان تتصاعد حتى الذروة.. دعونا نقتطف بعض زهراتها المرة في بدء تجليها .
يقول د.غلوم بأن التاريخ المسرحي الذي يفني التجريبي عمره من أجله هو خبرة بشرية واسعة متداخلة، وهو خيال فيه صور وأفكار (البدائي منها والمتوحش. الإنساني منها والشيطاني، الموضوعي منها والذاتي، البسيط منها والمعقد) ص 1 من الورقة .
ان العقلاني السابق ذكره، يتحول هنا الى اللاعقلاني، فتغدو الأشكال البدائية من الوعى الانسانى: الخرافات والسحر الشيطاني وغيرها من ضروب الوعي القديم في العصور السالفة ــ وهي التي عبرت عن علاقة صراعية بدائية مع الكون والاشياء الغامضة حينئذ ــ هي المرتكزات الاساسية لمسرح عصري يسمى تجربيباً.
ان الدعوة الى العقلانية، راحت تتشكل بصورة مغايرة للعقل، وهنا يشعر د. غلوم بتناقض حاسم وأساسي في دعوته، فيقول إن الانفتاح (لابد أن يبرهن على عقلانيته حتى مع حالات التعلق بفكرة حالمة أو جامحة أو مجنونة حول معنى المسرح) ص 2 .
ان هذا الشعور بالتضاد الحاد بين العقلاني والميتافيزيقي، بين التجريب والظلام، بين روح المختبرات الجسدية الخلاقة والجمود؛ لا يحل، بل يتنامى.
فالتجريب المفتوح الذي يطرحه الباحث لا يلبث ان يتوجه الى خبرات (بعيدة احياناً عن أشكال المسرح كالديانات وثقافة الشعوب البدائية من خرافات وأساطير وتقاليد وطقوس ورقص وغناء .. الخ) ص 2 .
لقد عاد من جديد الوعي البدائي، بصورة أكثر قوة وتفصيلا. فتركز العقلانى فى الخرافي، وصار التجريب مفتوحاً على مخزن وحيد، هو ثقافة الشعوب البدائية، مقطوعة من سياقها الصراعي الخاص، وشرطها التاريخي، مجرجرة إلى وعينا المعاصر. ولكن ماذا سوف نستل للتجريب المسرحي من هذه الثقافة البدائية..؟
ليس ثمة برنامج ملموس، ولكن شذرات من رؤى أخرين. فالمثل «الأكثر دهشة» هو مثال انتونان أرتو (حين ترك لخياله التنبوئي أن يكتشف من مجرد النظر في لوحة تشكيلية لرسام بدائي ما يجب أن يكون عليه المعنى الحقيقي للمسرح) ص 2.
هكذا يغدو التجريب المسرحي متعلقا بنظرة ألقاها أرتو على لوحة فنان يسميه «بدائياً». ولكن مسلسل اعتراف أرتو يكشف أنه ليس فناناً بدائياً بل مسيحياً .. فهو يقول ــ أي أرتوــ بعدئذ حسب مقتطف غلوم (أطلق ذلك الرسام على اللوحة اسم لوط وبناته.. وهذه اللوحة مثال غريب للاستنتاجات الصوفية..) ص 2.
ان العالم البدائي، يختلف عن العصور الوسطى الاقطاعية الدينية؛ ولكن ارتو في خطأه اللغوي ــ التاريخي، واستدلاله للتطور المتنوع للبشرية، في مظهر وحيد هو الوعي الديني ــ الصوفي؛ لن يرى أية فروق مادام هذا الوعي الصوفي، المقطوع الصلة بتكويناته الاجتماعية التاريخية، هو المهيمن سواء كان «بدائياً» أم «مسيحياً اقطاعياً» منقطعاً عن الحياة، متحولاً إلى نفثة سحرية. وعلينا ان نعرف ان هذا الرسام، الذي على التجريب المسرحي أن يبدأ من نفثته، هو قبل عصر التنوير والثورة الصناعية، أي ينبغي إلغاء التيارات التنويرية العقلانية الديمقراطية، والعودة الى ما قبل تشكلها، الى العصور الوسطى، الى الحياة البدائية، الى السحر !
من هذه النفثة السحرية؛ الطقسية، الاسطورية؛ البدائية، الغامضة؛ على التجريب المسرحي أن يبدأ؛ ولم ذلك؟ لم الانحصار في الغيب المقطوع الصلة بالهموم البشرية. بالآمال القومية، بالتغيير؟!
بالنسبة لآرتو ــ في السياق الذي وضعه فيه غلوم ــ وعالمه الراسمالي المهيمن على البشرية؛ النازف منها الدم والعظم، ستغدو هذه التجريبية الصوفية؛ لعبة لمثقفين ليست أمامهم قضايا ساخنة. عزلوا المسرح عن الحياة، وقطعوا شرايينه، واستلوا شرياناً واحداً يغيب كل شيء، وبحثوا في تاريخ البشر الآخرين، عن لحظات غيبية صوفية، تؤكد انغلاقهم الذاتي، كما تؤبد الشعوب الأخرى «البدائية» في لحظاتها الغيبية الصوفية، وبالتالي تستمر لعبة النازف والمنزوف.
ومن هنا يؤكد د.غلوم، على أهمية أن يتحد «العقل التجريبي» العربي مع «العقل التجريبي الأوربي»؛ ولكن ليس التجريبي العلمي، بل الصوفيٍ الغيبي.
ومن هنا كان من البدهي أن يلغي هذا العقل الفروق العرقية والقومية وأن يقف ضد أشكال التمييز العنصري وأن ينتصر لثقافة الشعوب الفقيرة والبدائية.. والا يجد امكانية اكتشاف لغة المسرح الخاصة أو شكله في تكنولوجيا ثقافة الغرب بقدر ما يجدها في ثقافة الشعوب المعزولة) ص 3.
هنا يتحد العقل التجريبي العربي الصوفي؛ المضاد للعقلانية، بالعقل التجريبي «الصوفي الأوربي»؛ في لحظة شيخوخته العقلية ــ الفنية، عائدين الى السحر والبدائية رافضين الاثنين معاً تكنولوجيا الغرب الصناعي المتقدم الديمقراطى، راجعين الى ثقافة الشعوب «المعزولة» لا المنفتحة، البدائية، لا العصرية، هروباً من اسئلة الموقف، وابتعاداً عن دفع ضريبة الفعل الثقافي النقدي.
الانفتاح هو التوجه الى الصوفية، برأي غلوم، والانغلاق هو السير نحو العلم، واذا اردنا ان نؤسس تجريبا إبداعيا مسرحيا، فعلينا أن نفارق عزلتنا «المحلية» و«القومية» وقضايانا المصيرية، لنتحد بتلك الومضة الصوفية عند آرتو في ذلك الوعي الصوفي الإلهامي عند الرسام القروسطي فهناك يوجد الانفتاح والعقل والبشرية المتألفة !
و تتنامى هذه البذرة وضوحا وتناقضا متزايدا، حين تصل بعدئذ الى تجليها الفكري، حين تسفر عن وجهها الايدلوجي، بوضوح. لماذا؟
(لان التجريب انحياز خالص لمعنى المسرح وتنحية مطلقة لاي انحياز ايدلوجي أو عرقي أم اقليمي مسبق). ص 5.
حين يكون التجريب الأوربي انحيازا للصوفية، للوعي البدائي المنقطع عن جذور عصره، سيكون (انحيازا خالصا لمعنى المسرح)، لكن حين يكون التجريب العربي انحيازا لقضايا الامة العربية المستعبدة، المقهورة، المتخلفة، واسئلة لاثارة وعيها وحركتها فسوف يكون انحيازا ايدلوجيا مرفوضا.
فالجمع بين التجريب المسرحي، وإشعال وعي الأمة، هو أمر غير ممكن في عرف د.غلوم، والانفتاح والعقلانية هو في الطلاق بينهما.
إن التجريب هنا يتحول طبقا لسياق الأفكار، الى بوليس صوفي يمنع اي هرطقة اجتماعية نقدية، أو اي شعور قومى، مؤكدا بهذا تحوله الى اداة للحفاظ على العلاقات اللامتكافئة بين غرب متقدم؛ وشرق متخلف عليه أن يبقى دائما في حضن ثقافته البدائية الجميلة!
إذا كان د.إبراهيم غلوم يفصل بين الفكرة والفن، وبين الأيديولوجيا والتجريب المسرحي، فإنه يواصل محاربة «الفكرة» داخل العمل المسرحي ذاته، مَلغِياً أشكال تَجِلْيَهَا ووجودها وتناميها في العرض المسرحي.. أو قل بأن فكرته اللاعقلانية تواصل طرد تجليات العقل في العرض.
فأي فكرة فنية لا تظهر إلا عبر الشخصية، والمعالجات، والأحداث، واللغة، ولا يوجد فن درامي ــ قصصي دون نمذجة وتجسيد.
ولكنه يصر على إلغاء هذه النمذجة عصب الفن الدرامي (والأنماط التي اعنيها هي الأنماط بجوهرها الشامل والذي نراه في طريقة بناء الشخصيات والأفكار والأساليب والمعالجات والحلول التي يقتضيها الأخذ بمنطق الأشياء) ص 6.
وهو يحولها من نمذجة إلى أنماط، بقصد استلال تنوعها وثرائها، وتصويرها في قالب آلى نمطي؛ ليسهل عليه دحرها.
وهو يحول هذه الأنماط ــ النماذج، الى سلطة قامعة للابداع. وليس إلى وسائل لثرائه كما فعل الإبداع منذ القدم حتى العصر الحديث؛ منذ سوفوكليس الى شكسبير الى نجيب سرور وسعدالله ونوس وبريخت الخ ..
وهو يريد التوجه إلى الغاء النمذجة ذاتها، وليس الطابع الآلي في النمط؛ كما يصور الأمر. فيقول عن التجريبيين العرب أمثال سعدالله ونوس ونجيب سرور وسلطة «الأنماط»، (فنجد أنها قد انتزعتهم من مهمة البحث عن جوهر المسرح، وألقت بهم في ضجيع الموضوعات وقضايا الأيديولوجيا،) ص 6.
ان النقد هنا لا يوجه الى الايدلوجيا والموضوعات فحسب، بل الى عصب الفن، وهو تجسيد النماذج – الحالات. فلن تؤدي النمذجة الا الى الارتباط بالواقع، وحياة الأمة ومشكلات المجتمع. لكن «جوهر المسرح» ــ حسب غلوم ــ هو كيان جوهري مفارق للاشياء، سرمدي، غامض؛ غير ملوث بوحل الحياة.
هنا لا يلغي الامة وقضاياها فحسب، بل يلغى الفن المسرحي أيضاً؛ انه يحوله الى رماد وغبار.
تبدأ المسيرة اللاعقلانية من السحر والبدائية والجنون الى الصوفية إلى إلغاء الفكرة والايدلوجيا والغاء الحالات والنماذج والمعالجات. لكنه ايضاً يواصل رحلة الهدم الغريبة هذه حتى يصل الى الغاء اللغة الادبية ذاتها :
(ان سلطة الكلمة في نصوص التجريب المسرحي استجابه طبيعية لسلطة الأيديولوجيا ولارتفاع صوت الخطاب السياسي)، ص 7، ويضيف (ونرى الآن أن إثبات الهوية العربية على المسرح مسألة تتناقض مع فعل التجريب؛ لأن العقل التجريبي يفترض إلغاء حواجز الهوية) ص 8 .
فالتجربب القادم من شطحات الصوفيين الغربيين؛ في عالمهم الامبريالي
المسيطر، مدعو للتسيد المطلق على التجريب العربى. إلغاء قضاياه وانتماءاته الفكرية، إزالة شخصياته وحالاته، إعدام هويته العربية، اشحاب لغته ..
هكذا يغدو «المسرح» فكرة غيبية، خارج التضاريس القومية والاجتماعية،
واللغة الإبداعية، ويتحول الى جوهر صوفي مفارق للمشكلات والنماذج والحالات ..
ولكن حتى هذا الجوهر النهائي الغامض لا نعرف اشكال وجوده الفنية، فما هو برنامج اخراجه وممثله وكيف سيظهر وقد قطع كل شرايينه مع الواقع والأشياء؟
نافذة
التجريب في الفن ليس من المحرمات، ولم يصدر أحد فرمانا بمنعه، ولم يتجرأ مبدع أو فنان، ان يعتبر ذاته خاتمة المطاف، ونهاية الخلق والإبداع.
وكان التاريخ الفني للبشرية يتجه دوماً للابتكار والتقدم، بدءاً من رسوم الصيادين على الكهوف إلى الملاحم الشعرية عند الفرس وأهل الرافدين والاغريق، وحتى الماساة الشكسبيرية وروائع تولستوي ومحفوظ الخ..
لقد كان التقدم الإبداعي هو زهرة تطور الروح البشرية، هو اقصى ما توصل اليه الانسان ليسيطر على عالمه، وذاته، ويعيد خلقهما باتجاه كون أكثر إنسانية وعدالة.
وكانت مسارات التطور في هذا الابداع تعتمد على تطور الوعي، الروح الوثابة لتشكيل العالم، آخذين في عين الاعتبار، مستويات التطور الاجتماعي – الاقتصادي. ومن هذين الجانبين كانت تتشكل تداخلات معقدة. ففي الوقت الذي كان العرب يتجهون فيه للانهيار في العصر الوسيط، كانت نتاجاتهم الإبداعية والثقافية قد وصلت الى الذروة، وفي الوقت الذي يعانون فيه الآن من التخلف، إلا أنهم أكثر إبداعاً في الرواية والقصة والمسرح من أوربا المعاصرة، بل يلحظ بشكل عام، هذا الابداع الأدبي والفني في العالم المتخلف «الثالث» قياساً بالغرب.
وليس ذلك إلا نتيجة للتكلس الروحي في الغرب، والغلبة الهائلة للمصلحة الانانية وبرود العلاقات البشرية، وفي فرنسا يمكن ملاحظة كيف تلاشت الاسماء الكبيرة سارتر، كامي دي بفوار، لتحل حالة من الفتور والانطفاء.
إن تطور الفنون يمكن أن يلحظ بدقة، في ذلك الهاجس المضطرم النابض بضرورة التغيير وتجاوز تخلف وألم الانسان. في الشعور بالتضحية ونكران الذات في الوعي باعادة تشكيل الأشياء الصعبة المؤلمة.
لقد ارتبطت تطورات الفنون دوماً بالوعي ومستويات نضجه. ففي حين تشكلت الاسطورة، الملحمة القديمة، القصة السحرية وغيرها فوق الوعي الأسطوري الخرافي، فان فنون وآداب العصور الوسطى من القصيدة الكلاسيكية. والملحمة والقصة الشعبية فوق الوعي الديني وما يرتبط به من ممارسات واشكال دنيوية.. في حين عرفت آداب وفنون العصور الحديثة هذا التوجه المتعدد الأشكال لقراءة الواقع، وتصاعدت لغة العلم في الأدب.
ويمكن ملاحظة أن تطور الفنون ارتبط كذلك بلحظات التغيير الكبرى في حياة الأمم، فالمرحلة الاولى من تطور البشرية الفني ارتبطت بالحضارات القديمة، مصر، بابل، الإغريق، الصين.
والمرحلة الثانية بالعرب والفرس وحضارة العصر الوسيط، في حين ارتبطت الثالثة بأوربا وهي تنزع أردية الإقطاع وتلبس الحداثة.
ان تطور الابداع لا يقوم على الفراغ، بل على الحاجات الحيوية للأمم في إعادة تشكيل ذاتها، وبناء لحظة حضارية متقدمة توسع حاجات الإنسان وحقوقه. واذا نظرنا بسرعة الى الآداب والفنون العربية في القرن العشرين نجد ذلك الانتقال المدهش من لحظة التعلم الساذجة الى خلق الفنون الخاصة القومية – الانسانية، بأشكالها الحديثة الأوربية، والدخول في لحظة تميز إبداعية واسعة في الرواية والمسرح والقصة القصيرة ، في العقود الأخيرة. ونجد هذه الآداب العربية وهي تتوغل في عوالمها المحلية – القومية، معيدة النظر في أسسها.
ع. خ
November 8, 2023
عبدالله خليفة رائد الثقافة التنويرية البحرينية
الثقافة البحرينية التنويرية على موعد مع تكريم رائدها التنويري الكبير عبدالله خليفة: وفاء لجل اعماله الادبية والفكرية والثقافيّة الذي افنى زهرة حياته فيها بنكران ذات تماهيا جللاً للبحرين وعصب حياتها من الفقراء والمعدمين فيها. فالثقافة كما يراها عبدالله خليفة عليها أن تكون لحركة التاريخ التنويرية وإذا فقدت انحيازها لحركة التاريخ فقدت قيمتها الانسانية واصبحت خاوية بلا معنى في التاريخ. أنسنة الثقافة عند عبدالله خليفة تجدها في ضجيج عطاءاته الفكرية والادبية وفي مجمل انشطته الثقافية والفكرية ناهيك عن تجلياته في صميم رواياته وسياق تحليلاته الثقافية والسياسية فقد اختار طريقه ثقافياً بين اشواك الثقافة ليلتقط ورودها ويلقي بها في أحضان الوطن… هذا البحريني المترع بوطنيته البحرينية صاخب التمرد فالوطنية عند عبدالله خليفة لا تستقيم إلا في التمرد (…) فالثقافة تمرد في البحث عن جمالية الحياة من اجل وطن جميل مترع بوعي التمرد الثقافي على طريق الازدهار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي.
أن تُراث عبدالله خليفة الأدبي والفكري والثقافي والروائي هو بيننا ثقافة تنويرية حرّة تتنفس بها الأجيال البحرينية جيلاً بعد جيل.
إن الثقافة البحرينية التنويرية على موعد في أن نبتهج جميعاً بتكريم الاديب والمفكر التنويري الراحل والغالي عبدالله خليفة.
ان هذا الاحتفاء التكريمي في شخص فقيد الثقافة التنويرية عبدالله خليفة هو احتفاء بالثقافة البحرينية ودورها الريادي التنويري ليس في البحرين وإنما في الخليج والجزيرة العربية: فالثقافة التنويرية في وعي تجلياتها الأممية تضع بصماتها خارج نطاقاتها الانسانيّة أنها في أبدية انسنتها الثقافية الوطنية والأممية وكان الراحل البحريني الكبير عبدالله خليفة يجترح انسنته الثقافية الوطنية في انسنة اممية ثقافية تجترح كل ثقافات الدنيا في سلم دائم وحرية ابدية للانسانية على وجه الارض.
ان الراحل البحريني الكبير عبدالله خليفة هو نسيج وحده وخصوصية ثقافية بحرينية: أعطى الثقافة التنويرية البحرينية ما لم يُعطها أحد غيره وكان ثراً في عطاءاته الفكرية والأدبية والروائية بحيث لم يُجاريه أحد في مملكة البحرين وكان أن دفع بأكثر من خمسين مؤلفا في حركة التأليف والنشر فأثرى ثراء تنويريا مميزاً لم يُماثله في هذا الميدان أحد منا.
وان الوفاء الثقافي لهذا الرجل الفذ والإنسان هو مشاركة الثقافة والمثقفين البحرينيين في تكريمه، حيث تضيء شموع الثقافة ضياءها التنويرية كرماً في تكريمه…
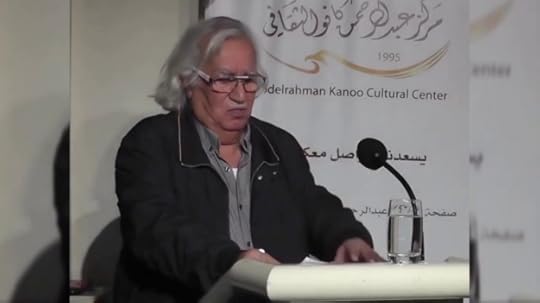
إسحاق الشيخ يعقوب
November 3, 2023
أين صواريخ ‹‹حزب الله›› على إسرائيل؟!
توقعنا يا سيدي حسن نصر الله أن تكون صواريخك على إسرائيل سحابة هائلة تمطرُ الدولة العدوانية بالنار والدمار. هذه هي ساعتك، وهذه هي لحظتك التاريخية، وطالما كنتَ تقول إن الدولة العبرية جبانة ولا تتحمل ضربات هائلة تأتيها من الشمال اللبناني والجنوب الفلسطيني، وحمست الفلسطينيين ودعوتهم لجهاد لا يقبل المساومة والتراجع والخيانة. كنتَ تؤكد – وقد أحببناك لهذا – بأن القضية هي قضية مصيرية عربية إسلامية، ووقوف مشترك، لا يقبل التراجع لضرب الدولة العبرية العابرة إن شاء الله من الأرض العربية، وقد أبليتَ في هذا بلاءً حسناً عظيماً. ثم جاءت المناسبة الكبيرة ليتحقق هذا الحلم. غزة محاصرة تـُضربُ من كل الجهات، أمطارٌ من القنابل تنزل عليها وقد صارت هي مطر الشتاء القارس، طائرات تضربُ بدقةٍ متناهية بيوت المناضلين والمجاهدين، ولا شيء يمتنع عن القصف؛ مساجد وكنائس ومنازل، أماكن للمقاومة وأماكن للعيش، وطرق ومؤسسات، والعالم كله يتفرج! الدولة العبرية الفاشية استباحت الوجود العالمي ومنظمة الأمم المتفرقة، وجامعة الدول العربية للدروس الخصوصية، التي تواصل طلب معونة الشتاء الدولية. كنت يا سيدي سيد المرحلة ودعوت في كل حين بضرب إسرائيل، ورفضت أي تقييد، وصرخت بأعلى صوتك بأن يتجمع الرصاص والصواريخ وسوف يهرب الإسرائيليون. ولكن ذلك لم يحدث! وربما طلبتَ سراً من الاخوة الحكام السوريين أن يفتحوا جبهة الجولان الباردة خلال ثلاثين سنة، لم تـُطلق منها رصاصة واحدة. وربما استعجلت صواريخ نجاد ولكنه مشغول بزراعة الطماطم الثورية. تحملتَ كثيراً من غدر الدول ومؤامراتها وخبثها، ثم لم تجد سوى أن تطالب بفتح الممرات بين مصر وغزة. صرخت ولكنك ابتعدت عن نقد القوى التي هيجت وحمست وأرادت من كل الأطراف أن تجاهد وتتفجر قنابل ومتفجرات وضحايا إلا هي اختارت السلامة وبر الأمان وجمع الدولار والتومان. كان ضرب أخوتنا الفلسطينيين وذكرى سيد الشهداء الحسين عليه السلام تجري، فأي أمة هذه تحتفل بسيد الشهداء وتنسى الشهادة؟ وفي ذكرى إمام المسلمين المجاهد ضد التسلط كنا بحاجة لتجميع كل القوى حتى لا نكون فرقة ضعيفة صغيرة معزولة وراءها عدو وأمامها عدو ولا سبيل لها لماء الخلاص! كنا لابد خلال هذه السنوات كلها من تجميع الصفوف الوطنية وعدم الوقوع في شبكات الدول المحتالة، وشعارات الطوائف، حتى لا نقع في مثل موقفنا الراهن أسرى لشبكاتها واحتيالاتها، نطلق الصواريخ بحساب أجندتها. وثم ندفع أثماناً باهظة عجزاً عن إسلامية التوحيد من أجل طوائفية الدول وايديولوجيات التفريق وحسابات الدول الخاصة. ولكننا بالعكس نقدر موقفك يا سيدي في عدم اقتحام الموقف العسكري الخطر، فقد أبليت ولا تريد توريط بلدك في حرب غير مستعدة لها ولا هي قادرة على الدخول فيها وحيدة. ووجودك قوة سياسية معاضدة ومنتقدة ومناضلة داخل أجهزة بلدك ومن أجل شعبك أفضل من دخول معركة، يغدو لبنان الخاسر فيها، لأنك إذا حولت بلدك ساحة وطنية إسلامية مسيحية متعاضدة تقدم مثالاً جهادياً أكبر من إطلاق صواريخ. صارت الصواريخ باردة لأن دول الطوائف وحساباتها صارت سائدة. ومثلما تركوك وحيداً تركوا غزة وحيدة. لكن هذه هي الدروس التي نستخلصها من أنظمة بيروقراطية بوليسية تردد كلمات الجهاد والقضاء على إسرائيل حتى إذا جاءت لحظة الحساب بحثت عن مصالحها وتفاوضت من أجل استمرار الجبهات الباردة. وقد دفع لبنان أثماناً غالية في سبيل القضية القومية التي لم يدفع الآخرون أي ثمن لها باستثناء مصر. ويغدو الصراخ على الحكومة المصرية هو أحد أشكال النضال المحدودة في هذا الزمن الصعب، لكن مصر وحيدة لا تستطيع أن تفعل شيئاً كبيراً. لتبقى صواريخ حزب الله باردة وتنتظر فرصة أخرى حين تقدر الحكومات العربية والإسلامية على التقارب، بدلاً من التكالب لمصالحها. ولتتجمع الشعوب العربية والإسلامية وتدفع ضرائب من الدم، وتنسى طوائفها ومصالحها الضيقة، وتنسى اسطوانة سنة وشيعة. فليس لبنان دائماً هو الضحية ودافع الضرائب القومية. لكن يبقى يا سيدي حسن نصرالله أن تقول الحقيقة اليوم أو غداً، حتى تتعلم الأجيال ماذا يجري ولا تنخدع، وتتوحد، وتدع التفرق الديني والطائفي، لتجابه دراكوالات الحكومات المهيمنة على كل شيء. ولا يكون تحرير الأراضي العربية المحتلة بغير ذلك. ألم يترك حزب الله وحيداً؟ ألم تترك غزة وحيدة؟ هذه هي نتائج السياسات الطائفية والأحزاب الطائفية. التوحد وليس مغامرات الجماعات الصغيرة هو السبيل، إن التوحيد لكل الطوائف والقوميات والأديان في هذه المنطقة للقضاء على الاحتلال والاستغلال.
12 يناير 2009
حزب الله في لبنان
إن البناء الاجتماعي يحدد بشكل عام توجه أي حزب حتى لو كان قادماً من الخارج، فالبناء يعيد تكييف التنظيم حسب طبيعة المجتمع الذي يعمل فيه، رغم أن العديد من الأحزاب تحاول أن تحافظ على بنيتها الجوهرية المستوردة، لكنها لا تستطيع أن تستمر إلى الأبد في عملية التبعية، لأن الأرضَ التي تشتغلُ فيها لها طبيعة مختلفة.
ومن ثم فإن الشكل التنظيمي لحزب الله بين إيران ولبنان كان هو نفسه، وتغدو المرجعية المذهبية والمصادر الفكرية هي نفسها كذلك، وهذا أمر يقود الحزب إلى ازدواجية بين جذوره وبين البناء الذي يشتغل فيه.
وإذا كان قد تشكل في إيران كأداة لدولة شمولية، فإنه في لبنان تشكل كانشقاق من تنظيم بدأ متهادنا وغير قتالي، فصار دوره في إيران قمعياً، وتناميه في المجتمع محدودا بسبب الانفصال بين مؤسسات الدولة الدينية المتعالية وجمهور الشعب.
في حين كان الأمر في لبنان مختلفاً، فليس هو جزء من بنية الدولة القامعة، صحيح انه ارتبط بالتحالف السوري – الإيراني، وكان بعيدا عن عمليات القمع التي وجهت للمعارضة الديمقراطية، لكنه لم يحاول أن يزج بنفسه في مثل هذه العمليات، ولم يعتبر نفسه طرفاً في إضطهاد طائفة لبنانية أو فريق..
إن الموضوعية في التحليل تقودنا إلى التمييز بين جماعة وجماعة في نفس الخط الإيديولوجي، وعدم سلق النتائج والاتهامات.
نعم إن بناء تنظيم بمثل هذا الاسم يحمل دلالات سلبية، لأن الإسلام كيان فكرى مفتوح، وفي أمور الجهاد يتوجه إلى التنظيمات الجبهوية، التي تشمل كل المتضررين من الاحتلال أو الاضطهاد الاجنبي، من دون تفرقة بين مذهب وآخر وبين دين ودين، وبين فكر وفكر، لأنه لا جنسية للضرر ولا ملة للخطر.
في بناء سياسي استبدادي سوف يتحول التنظيم إلى إضافة جديدة واتساع كمي، لكنه في بلد متحضر و(ديمقراطي) سيتأثر بالمناخ، وحين ينخرط في النضال الوطني ستكون مساهمته مهمة بهذا الشأن.
إن إشكالية الفهم التقليدي المسيطر في سوريا وإيران هو الذي لعب دوره في تحجيم التطور الديمقراطي داخل هذين المجتمعين، كما أدى إلى تفجير الصدامات مع القوى الخارجية، التي بدورها استغلت عدم المرونة هذه في جر المجتمعين الإيرانى والسوري إلى المواجهات لتكسيرهما، وهي أمورٌ راحت تتحملها بلدان المنطقة وشعوبها جميعاً.
فإذا كان الحزب منخرطاً في هذه الاستراتيجية تغدو المسألة مركبة ومتعددة الأوجه، فهو يدخل لعبة سياسية أكبر منه، لعبة دول كبيرة، يغدو هو منتصرا في جانب منها، وضحية في جانب آخر.
وإذا كانت القضية نضالية وموجهة لعدو تغدو كذلك محدودة، لأن الدولتين الراعيتين للحزب لا تريدانها شعبية جبهوية ووطنية لبنانية، مثلما أن المعركة ضد القوى الغربية تغدو لديهما ضيقة ومحدودة، وللعجز عن التطور أكثر منه عداءٍ حقيقياً للتبعية.
إنها سياسة تحجم من الاصطفاف الوطني النضالي في لبنان ضد الصهيونية وتحجم كذلك الاصطفاف النضالي للدول العربية ضد التبعية، بأن تجعلها ذات مقاييس مذهبية وطريقة جامدة.
فيفترض في السياسة النضالية أن توسع القوى وتحشد الدول لما هو ممكن، وليس أن تخلق سياسة محاور تعود بالضرر على دول المنطقة أكثر من غيرها.
وفي حين ابتعدت الدولتان الإسلاميتان عن مساندة حزب الله في المعركة كان العدوان ضارياً، وثبت أن الشعب وحده هو الحامي لأي حزب، وهو جذوره وأعماقه.
كما أن القوى اللبنانية وجدت نفسها في خندق واحد، ومن هنا اتجهت التطورات اللاحقة إلى مواقف إيجابية أكثر من حزب الله تجاه التعاون مع الحكومة اللبنانية والترابط مع الشعب وعدم الرد المراهق على سياسة التعسف الإسرائيلية.
وهكذا فإن النضال الوطني رغم جسامة العدوان كان هو أقوى من الجذور الخارجية، والداخل هو الذي يصهر أي حزب على المدى الطويل.
إن عملية الانصهار هي قضية ديمقراطية عميقة تتعلق بمدى تطور الوعي الشعبي اللبناني وانحيازه للوطنية، وذوبان الطوائف، وصعود دور الطبقات الوطنية الأساسية، البرجوازية الوطنية والعمال، ومن دون هذه العوامل الموضوعية فإن الطائفية ستظل هي المحرك الإيديولوجي والسياسي للأحداث، وبالتالي فإن صراع الطوائف سيعود مجدداً برغم الهدنة الحربية.
2006-9-6
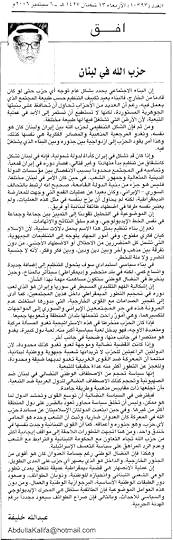
الجذور الاجتماعية والفكرية لحزب الله
إذا كان حزب الله قد تشكل في خضم الثورة الإيرانية الشعبية فهذا أمرٌ قاد إلى مجموعة من الظواهر المتشابكة الإيجابية والسلبية، فذلك قد حرك الجمهور الفقير الواسع النطاق الريفي المتدفق على العاصمة وعلى المدن أن يكون له تأثير على ساحة الأحداث وصياغة المستقبل السياسي للجمهورية. فلم يعد التاريخ تصنعه النخب والحكومة المتفردة بالقرارات، بل صار يتشكل كذلك في الأزقة.
ولكن نمو الأحداث كذلك، وتوجه القوى المهيمنة للنظام القديم لتسليم السلطة لرجال الدين، قد جعل ذلك الزخم الشعبي الديمقراطي الثوري يتجمد في سلطة نصوصية محافظة، هي نتاج سيطرة الإقطاع خلال ألف سنة سابقة، مظهرت الوجود الإسلامي في شعائر وتنظيمات اجتماعية لا تصل إلى زخم الثورة الإسلامية التأسيسية، التي أقامت ديمقراطية مباشرة، وأعطت الأرض العامة والدخل للجمهور.
ولم يكن أمام المحافظين الدينيين إلا أن يفرملوا زخم الاندفاع الجماهيري ويؤطروه في مؤسسات يسيطرون عليها، وتحد من حركة الجمهور الحرة.
وهكذا عاشت عملية الارتداد عن الثورة طابعين متضادين، الأول تمظهر في تحول الدولة إلى (الأب) الراعى للجمهور الفقير. فأقامت المؤسسات الراعية له، كمؤسسات الشهداء وجعلت القطاع العام الهائل تابعاً لها، وهو القطاع الذي يجمع في يديه أكبر الثروات. وهو الذي يقدم وظائف كثيرة لجمهور عاطل وزراعي مقتلع من أرضه.
ومن جانب آخر، فإن الدولة كانت راعية كذلك لتجار البازار وقوى الملكية الخاصة المختلفة، وهو القسم الذي كان يتطور باتجاه الحد من هيمنة الدولة على الفضاء الاقتصادي.
وهكذا فإن فقراء حزب الله وجدوا أنفسهم معادين لليبرالية والديمقراطية، وهم أبناء الثورة، حيث ساندوا بقوة تضخم الدولة وسيطرتها وتدخلها في شتى نواحي الحياة، لأنهم في المتواري من لا وعيهم، يرغبون في اشتراكية، لكنها دينية، يهيمن عليها الإقطاع بمظلته الفكرية، حيث تكون الملكيات الأساسية للناس، وبالتالي كانوا يقرأون جميع المسائل بشكل خاطئ تاريخياً.
فالرأسمالية تشق طريقها، وقد قيل للشعبيين الروس في القرن التاسع عشر إن الرأسمالية منتصرة، لكنهم رفضوا ذلك، وقد حقق لهم البلاشفة حلمهم إلى حين، وهكذا فإن أعضاء حزب الله هم هؤلاء الشعبيون لكنهم إيرانيون، ولهم قرناؤهم في كافة البلدان التي تواجه العمليات التمزيقية للرأسمالية، لكنها الضرورية في مجرى التاريخ الراهن، والقليل منهم سوف يتغلغل في مطبخ الحكومة ليكون ثروات، في حين ستقع الأغلبية في حضن العمال.
إن (الاشتراكية) الدينية هذه تُرفد بالتراث الشيعي الإمامي غير المقروء بفكر حديث، والذي غطت على لآلئه أفكار الغيب وقطع جذوره عن الفعل الشعبي الديمقراطي للإمام المؤسس، ذلك الفعل الذي لا يعترف بالقسوة والاصطياد ويتوجه للعدل والكرامة الإنسانية، بشفافية وبحضور الناس الفاعل، ولكن القمع الذي تشكل في عهد الدول غطى على تلك الجمرات المتوارية، فقُدمت أشكالٌ وتنظيمات شعبية تعاضدية بسيطة لكنها لا تجمع بين التعاون والحرية، بين النضال الجماعي والديمقراطية، بين الانتماء للإمام وبين الثورة المعاصرة الحديثة.
وهكذا غدا حزب الله مع نمو سيطرة المحافظين، أصحاب الملايين على الدولة والثروة، باتجاه التخلي عن أحلام الفقراء الذين ظهر من بينهم، وبدلاً من أن يتجاوز هيمنة الدولة الشمولية بدولة يسيطر فيها القطاع العام بشكل ديمقراطى، ارتهن بهذه الدولة الشمولية التى تسرق الفقراء باسم الإسلام وتنمي ثروات البرجوازية الحكومية وتجار البازار باسم النظام (الإسلامي)..
إن عدم انضواء حزب الله تحت مظلة الفكر الديمقراطي هو بسبب تصوره بأن الديمقراطية ليس لها سوى شكل غربي، يترافق مع الاباحية، وأن المسلمين عاجزون عن إنتاج شكل ديمقراطي حقيقي وغير متضاد مع جذورهم ومثلهم الأخلاقية، وهو وهم لا تزيله سوى قدرات القوى الطليعية بالجمع بين الديمقراطية والإسلام، بين الجذور والمعاصرة.
وهو وهم تكرسه قوى المحافظين الخائفين على الأموال التي سرقوها بهذه الدكتاتورية الدينية.
2006-9-2
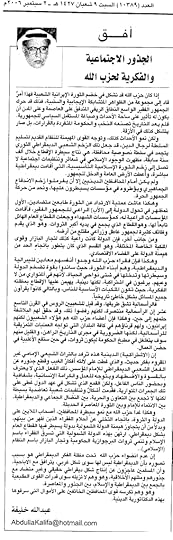
October 31, 2023
[الغرباء]
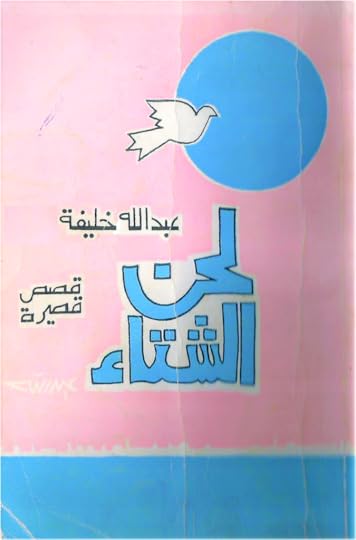
قصـــــــةٌ قصـــــــــيرةٌ
✺✺✺✺
صحوت من نومي على أثر رفسات في بطني. شاهدت ثلاثة أشخاص في المنزل. رجلان وامرأة. الرجل الكبير السن ضخم، متين البنية. راح يتكلم لغة أجهلها تماماً. أعتقدت في بادئ الأمر إنه مجرد حلم. فما أكثر الأحلام التي أرى.
جرني الرجلان من السرير.. (أنا ضعيف البنية).
– سريري! بيتي! ماذا تفعلان!؟
راح الرجل الضخم يتكلم مع المرأة التي يبدو أنها زوجته. كانت منفعلة قليلاً، يظهر أنها كانت تشاركني جزءاً يسيراً من عاطفتي الملتهبة.
أجلسني الرجل على الكرسي. وقف الشاب ورائي. الرجل الكبير تناول ورقة صفرا كبيرة، انطلق يقرأ ويقرأ. لم أفهم شيئاً.
فقلت:
– لا أفهم هذه اللغة أيها السادة، وهذا بيتي.
لم يهتم الرجل باحتجاجي. واصل القراءة.
– ماذا تريدون مني بصراحة؟!
فرغ من القراءة. ناولني الورقة. الورقة سميكة، مخططة، فيها كتابات وصور غريبة. صور بحر وسفن وبنوك وشركات.
– أهو فيلم أيها السادة أم مسرحية مرتجلة ما تقومون به؟
المرأة تصرخ. إنها متشنجة. لا شك أنها تدافع عني. لم يهتم الرجل بصراخها. ألقى الورقة. فجأة راح الرجل يرقص أمامي. (لا تقلد زوربا أيها الحقير) أشار في حركاته إلى بيتي. وإلى بلاد بعيدة، هذا البيت، يقول بالإشارة، بيتي. إنه لنا. أنت، لي أنا، أجنبي.
وقفت محتجاً:
– إنه منزلي، وأنتم الغرباء المحتلون!
مضى في رقصه، أشار إلى أنهم أقوياء، يملكون البر والبحر والجو، وأنه لا يحق لنا العيش هنا. الحيوانات الضعيفة لا مكان لها بين الوحوش القوية.
هدأ الرجل. كان العرق يتصبب منه. ثم أحسست بضربة عنيفة على صدغي من الخلف. أمسكني الرجلان بعنف أخرجاً حبلاً وربطاني بالكرسي.
– ما الذي تفعلانه؟! أيها الناس.. يا أهل الحي!
انطلقت في هتاف وصراخ عنيفين. وضع الشاب منديلاً قذراً في فمي.
هنا قامت المرأة ضاحكة. فتحت الباب ومضت. بعد لحظات كان عدة أطفال صغار يتدافعون إلى منزلي، أقصد المنزل. وقفوا أمامي. بدت الدهشة على وجوههم. كأنهم يشاهدون هندياً أحمر. اقترب أحدهم مني. يبدو أنّه متأثر. هتف به والده. ابتعد. ثم انطلق الصغار في أنحاء البيت يضحكون.
لا قدرة لي على الكلام. لا قدرة لي على التفسير. لا قدرة لي على الاحتجاج.
جاءت الأم مرة أخرى. معها الآن شابة نحيفة. رائعة الجمال. هل أنا وحش أيتها السيدة المحترمة جداً؟
أحضر الشاب العديد من كتب مكتبتي. ألقاها في الفناء. هتف للصغار بلغته الغريبة. فأسرع هؤلاء إلى الكتب يحملونها إلى الخارج.
إنها كتب عظيمة أيها السادة تحتوي أراء قيمة لمفكرين كبار خدموا البشرية. ألقوا ثيابي، أحرقوها، أما هذه فلا!
سمعت طرقات على الباب. مضى الوالد. بعد لحظة دخل مع ضابط المركز في حينا. فرحت كثيراً بمجيئه. كأنه على موعد مع هذا الكابوس. أنه أحمد، أحمد زميلي القديم في الدراسة، الذي كان يعتمد علي كثيراً أيام الامتحانات.
اقترب مني. نزع المنديل. هتفت:
– من هؤلاء؟ من هؤلاء الغجر؟
– …………..
– لقد حطموا أعصابي. أنقذني منهم. كدت أعتقد أنه حلم رهيب لن ينتهي.
– أصبر لحظة حتى نحقق في الموضوع.
– إنه بيتي يا أحمد. دخلوا علي، واحتلوا منزلي بكل قوة وعنف وبشكل لا أخلاقي.
ـ انتظر لحظة حتى أسمع أقوال السيد .
– تسمع أقواله…؟ ألا ترى وضعي الموضوعي..!
ثم منذ متى تعرف أنت لغة أجنبية؟؟
– إذا لم تسكت سأضع المنديل في فمك القذر.
كانت ضربة قاسية. ثم راح يستمع إلى حديث الرجل الضخم.
بعد لحظة نادى العديد من رجاله. أحاطوا بي. هتفت:
– ما هذا يا أحمد؟ سرقوا منزلي وأنت تساعدهم؟!
– أحمد الله على سلامتك. غيرك حدث له أسوأ مما حدث لك.
ـ آه يوجد غيري أيضاً! يا لها من لعبة قذرة!
– خذوه إلى السجن، حذار أن يفلت منكم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ツ لحن الشتاء (قصص)، دار الغد، المنامة/ البحرين، 1975 .
(القصص: الغرباء ـــ الملك ـــ هكذا تكلم عبدالمولى ـــ الكلاب ـــ اغتيال ـــ حامل البرق ـــ الملاذ ـــ السندباد ـــ لحن الشتاء ـــ الوحل ـــ نجمة الخليج ـــ الطائر ـــ القبر الكبير ـــ الصدى ـــ العين)
October 30, 2023
الغموض الإبداعي عزل للشكل عن المضمون، وللكاتب عن المجتمع
حاوره – كمال الذيب:
قضى الروائي والكاتب الصحفي البحريني المعروف عبدالله خليفة أكثر من 30 سنة يكتب في الصحافة الثقافية، وأكثر من 15 سنة مشرفا على الصفحات الثقافية، شاركته خلال الخمس سنوات الأولى في اصدار الملحق الثقافي في أخبار الخليج، محررا ومقدما للإصدارات الابداعية، البحرينية وشاركته أزمة هذه الصفحات وتقلباتها بين امزجة رؤساء التحرير، وكيف كان الجميع يضحي بالثقافة عند أول أزمة او ضائقة مالية تمس الصحيفة، لقد كانت الصفحات الثقافية جزءا من الظاهرة الثقافية، يعوزها كل شيء تقريبا، بالرغم من توافر الطاقات البشرية والإبداعية المتميزة. هذا النقص في الإمكانيات كان مرده بالدرجة الأولى إلى أن الكائن الثقافي منبوذ من كل الفئات والطبقات الاجتماعية.
هذا الموضوع كنت قد ناقشته مع القاص عبدالله خليفه قبل رحيله، عندما عقدت العزم على اجراء مسائلات مع عدد من الكتاب والمثقفين والفنانين البحرينيين المميزين، لتضمينها في إصدار حول الثقافة في البحرين، وكان عبدالله في مقدمة هؤلاء، إلا أن الاجل المحتوم وافاه قبل اصدار هذا الكتاب الذي ما يزال منذ اكثر من عام ونصف تحت الطبع، ولذلك عزمت على نشر جانب من هذه المحاورة حول أوضاع الصحافة الثقافية وتحولاتها واشكالاتها في البحرين، بما تسمح به المساحة المتاحة.
قلت لعبدالله: وكيف تقيم وضع الصفحات الثقافية وأنت أحد المشرفين عليها؟ وكيف انعكس الوضع الثقافي الراهن في تقديرك على مستوى الصفحات الثقافية؟
✤ الحديث عن الوضع الثقافي الراهن في البحرين والحالة الثقافية العامة وانعكاساتها على الصفحات الثقافية موضوع متشعب.إن علينا أولاً أن نقرأ الحالة الروحية في الثقافة، لقد كانت الحالة الثقافية في الستينات وبداية السبعينات صاخبة وقوية وحيّة، حيث كان توجه الأدب والثقافة نحو العمل الجريء، وكانت النصوص تصدر عن روح وثّابة شجاعة، لا تخاف من تحليل الحياة بمشرط حاد. ورغم أولية التجربة للجيل الشاب حينذاك، إلا أن ذلك الجيل كان قوياً جريئاً، يهز الحياة، ولا يخاف من عرض المشكلات والنقد، وكان الكثيرون يكتبون، ويبدعون، وينتقدون أنفسهم، وكانت الصحافة الأدبية تنشر ما يكتبونه فوراً، وكان يحصل على صداه. كانت القصص والقصائد تُناقش وتحلل في جلسات أدبية شخصية، وكان القراء على صلة بهذا النتاج. أذكر كيف كانت ندوات عديدة لأسرة الأدباء والكتّاب تُقام في أندية المنامة والمحرق المتعددة، داخل قاعات صغيرة، وترى حشوداً من الناس في هذه الغرف والقاعات مستمتعين بالحوار والنقد. وغالباً ما توضع الكتابات الجديدة على محك هذه اللقاءات، كانت قصصنا تُقرأ في ندوة، ويحدث حوار مفتوح لها، وأحياناً بدون أي إعداد مسبق، ولكن النقاش يفيض، والكاتب يحس أنه جزء من حياة، وجزء من بشر يقرأون، وليس حاله مثل الآن، يضاجع الأوراق فحسب التي لا تلد سوى الصمت. وكان رؤساء التحرير، من أمثال محمود المردي، وعلي سيار، وعبدالله المدني، أناساً مثقفين وأدباء، يتذوقون الكتابة الإبداعية، ولهم مشاركات فيها، وكانت تحدث حوارات مع الكتّاب من قبل رؤساء التحرير، هؤلاء الذين يناقشوننا في قصصنا، ويدعوننا للوضوح، وصياغة قصة أكثر تماسكاً، وعدم التركيز دائماً على السياسة. لقد كانت أسرة الأدباء والكتّاب منفتحة، تعددية، ذات مناخ ديمقراطي، وليس ثمة أي قطب يذوب فيه كل الأقطاب الأخرى، أو شلة تستولي على النشر وترتيب الندوات، كنّا أشبه بالجوالين والكشافة، ننتقل من نادٍ إلى ناد، ومن أمسية إلى ندوة، ونتحاور بقسوة أحياناً، ونكتب بضراوة وكثرة على مختلف الجبهات والصفحات. لم يكن الهدف من الكتابة الحصول على نقود أو شهرة بإحداث الفعل الثقافي التنويري. وكانت الندوات العامة التي تحدث في قاعة الأندية مليئة بالجمهور المتعطش إلى المعرفة، حيث كان الكتاب والصحيفة والندوة هي وسائل الإعلام القوية. لكن كل هذا تغيّر اليوم، وجاء مناخ ثقافي مختلف، عبر حدوث التغيرات الاقتصادية الاجتماعية الكبيرة. فالمدن صارت مليئة بالأجانب، وعزلت الأندية عن دورها الثقافي، وصارت محتكرة من قبل إدارات من أناس بعيدين عن الثقافة، ولذلك لا يقودها الأدباء والمفكرون، لقد عزلوها عن مناخها الفكري، وركزوا على الرياضة مما أدى إلى جعل الشباب بلا خلفية ثقافية. وأتذكر أن النادي الذي كان في منطقتنا، كان شعلة من النشاط الأدبي والفني، فيه فرقة مسرحية، وفرقة موسيقية، ومجلات حائطية، ومجلة مطبوعة، وكان يصنع العديد من الهواة في الثقافة، ويستضيف ندوات عديدة، ولكن عندما جاء أعداء الثقافة طردوا الفرق المسرحية والموسيقية، حتى أن أدوات الفرقة الموسيقية كانت تُرمى في الشارع، وهذا ما حدث في الكثير من مجالات الوعي، لقد بدأ مدٌّ رجعي معادٍ للثقافة. وهكذا أصبحت قوة الثقافة الوطنية «مخترقة» على كافة الجبهات، لقد كان العدو يطلع من صفوفنا، فظهرت نغمة «الشكلانية» الواسعة، ودعت الكتّاب للتخلي عن «الكلمة من أجل الإنسان» وصار الغموض لغة تفجيرية تؤدي إلى عزل الشكل عن المضمون، والكاتب عن المجتمع، وتؤدي إلى الغرق في متاهات تجريدية ولغزية تُدمّر الأدب من الداخل. ولقد فقدنا كتّاباً كثيرين بسبب هذه الطريقة، لأن مبادئ الوعي المضيء والوطني، واعتبار الكاتب قوة تغيير روحية في المجتمع، تضيع، ويتحول الكاتب إلى مهووس بذاته، وتشرخه أحلام جنون العظمة والتعملق الفارغ. ومن جانب آخر، فإن مشكلات الحياة الحادة المتفجرة مثل الصعوبة المادية تؤدي إلى فقدان البقية الباقية من الكتّاب. ولهذا فإن الواقع الفكري يتهشم ويتقزم، وتروح وتذهب عن الكاتب الهام والجريء فلا تجده، لقد ندر مثل الجن، وكأن الحياة الثقافية التي كانت تندفع مثل القطار في السابق أصبحت مثل سيارة مثقوبة الإطارين، ومع ذلك فإن سائقها يحاول السير بين الرمال والحصى. ولا شك أنك تدرك اليوم الفروق الكبيرة بين الصفحات الثقافية خلال الفترة من 1965-1975 والصفحات الثقافية في الثمانينات، حين كان النشر صعباً، كانت القصص والقصائد تفيض بالمعاني العميقة، وترتبط بهموم الناس، هذه القصص والقصائد يصعب نشرها في الصفحات الثقافية الآن.
إن هذا هو الأمر المثير للغرابة والحزن، فلن تجد في جرائدنا اليوم أي قصص وقصائد ملفتة، وجريئة ومثيرة للقلق والغضب، ولهذا فإن المبتدئين يحصلون على فرصتهم في نشر محاولاتهم الأولى في صفحات القراء فقط. وإن الأوضاع العامة تنعكس بقوة على الحياة الثقافية، فليس هناك احترام للاستقلالية الإبداعية وأهمية مستويات الثقافة المستقلة في البنية الاجتماعية. كما أن أدوات الإعلام الجماهيرية مثل التلفزيون والصحافة هي التي تلعب دورها في غسل أدمغة الناس، إنه الغسيل الإعلامي اليومي الذي يطحن الإرادة والوعي الناقد، ويحولهما إلى مسايرات جزئية وانطباعية ومحدودة لما يجري، إن الناس يعيشون في بناء إعلامي زائف، كرّسه النشاط الإعلامي اليومي الكاذب. فمشكلات الناس الجوهرية يجري تغييبها إعلامياً من قبل الإعلاميين أنفسهم، وإحلال مشكلات أخرى جزئية ومحدودة مكانها.
لقد كانت الصفحات الثقافية أحد المتنفسات والرئات النظيفة للوعي والمجتمع، ولكن تم الإجهاز عليها، فما ينشر من كتابات وأعمال اليوم بائس إلى أقصى درجة. وحتى مساحة الكتابة الأدبية قلّت، في حين تمددت مساحات الشعر النبطي، والدعاية، وقضايا «النجوم» المنطفئة، والكتابات السهلة المسطحة التافهة المنافقة.
إن وسائل الإعلام الجماهيرية، خاصةً التلفزيون، تقود عملية غسيل الأدمغة، وتضع الناس في أحلام وردية، ومشكلات جزئية بسرعة وخفة، ويتم التوجه إلى تغريب المواطن، وتسطيح وعيه. ولكن هناك جوانب إيجابية في هذه الثقافة، حيث أن الأقلام الجيدة منتشرة في الصحافة، ويوجد العديد من الكتّاب الذين يعالجون قضايا الحياة، والسياسة، والثقافة من منطلقات إيجابية.إن سيطرة وسائل الإعلام الجماهيرية قد قادت إلى تهميش الأدب والجماعات الحديثة، وأبرزت القوى العتيقة والطائفية، فلم يعد للناس منابر وأصوات مدافعة عن مشاكلهم، فلجأوا إلى المنابر الدينية، واتسعت الظاهرة الدينية لهذه الأسباب بالدرجة الأولى، في حين لم تستطع القوى الحديثة، الليبرالية والديمقراطية أن تظهر من خلال التلفزيون، فقدراتنا على صياغة فن جماهيري سواءً كان مسرحياً أو درامياً ضاعت لأسباب كثيرة، مثل عدم جديّة المسرحيين في التطور، والبحث الفني، وضآلة الإمكانيات المادية، والرقابة التي جمّدت الفنون الجماهيرية البحرينية عموماً، ولهذا عندما صغنا بعض الأعمال الدرامية التلفزيونية كانت أشبه ب «الفضيحة» مثل: «أم هلال في القاهرة»، في حين نجحت الأعمال التي التزمت بالجدية والنص الأدبي المعقول، واعتمدت على طاقة الشباب الوفيرة، هكذا مثلاً تألقت الكتابة الجميلة مع الوعي التنويري الجاد مع المواهب الشبابية، مع تنوّع العطاءات والطاقات الإبداعية، ليكون العمل الفني الدرامي أفضل من عشرين كتاب تنويري، لماذا؟ لأن المسلسل الدرامي له حضوره الجماهيري الواسع، فكيف سيكون الأمر لو تضافرت طاقات الكتابة المتنوعة داخل هذا الجهاز التلفزيوني الخطير، وأتيحت الفرص لمختلف الأقلام والأجيال الفاعلة التنويرية؟ لقد كان مسلسل «العائلة» المصري أهم من ألف كتاب عربي، فلماذا لا يحدث تعاون خلاق لإنتاج أمثال هذا المسلسل في خليجنا، حسب قدراتنا، ومشاكلنا؟ إن ما تحتاجه هو الثقافة البحرينية الحديثة «الديمقراطية» هو أن تتاح لها الفرص في مختلف وسائل الإعلام الجماهيرية، وأن يتعلم الكتّاب استخدامها، وتطوير أعمالهم الإبداعية في مختلف الجهات.
قلت لعبدالله: الصفحات الثقافية تبدو مشوهة في إطار ما ينبغي أن نقوم به من دور في الساحة الثقافية، فهي منزوعة الوظيفة تعيش في حالة من الهلامية الرخوة بلا عظام، فما الحل من وجهة نظرك لتستقيم هذه الصفحات؟

✤ ما لم تصبح الثقافة ضرورة فلن تنمو لها عظام، ولن تتحول إلى مشروع. وهذا شأن كل الصفحات الثقافية فهذه الصفحات بلا رؤية وبلا استراتيجية. وإذا أريد للثقافة أن تكون مشروعاً، فإن الصفحات الثقافية يمكن أن تكون جزءاً من هذا المشروع، المطلوب هو أن تتحول الصفحات الثقافية إلى جزء من رؤية ثقافية وفكرية تخدم حركة التاريخ…أما والثقافة مهمشة في واقعنا العربي، فستظل الصفحات الثقافية مجرد ورقة توت نغطي بها عوراتنا لنقول إننا نهتم بالثقافة. وتطوير الصفحات الثقافية يجب ان يتصل بتطوير الثقافة نفسها، وتطوير الثقافة يجب ان يرتبط بقانون الفعل الثقافي، لا بد من وجهة نظري أن تتحول الصفحات الثقافية إلى شريحة من الواقع الثقافي، يقودها ويكتبها وينشطها شعراء وقاصون ونقاد ومفكرون، ولا بد أن يكون في كل صحيفة قسم ثقافي ينخرط فيه عدد من المتحاورين والمثقفين والمبدعين والمفكرين.
أمين صالح: ملاحظات حول مجموعة : الفراشات
هذه هي المجموعة الثانية للقاص أمين صالح الصادرة عن دار الغد بالبحرين، والتي تعتبر امتداداً وتعميقاً للخط الذي شقه لنفسه في ميدان القصة . اننا لن تعتبر هذا الامتداد تطوراً وقفزة إلى الأمام ، بل سنجد فيه استمراراً لأزمة هذا العالم الأدبي الفكرية والفنية .
إن إطلاق النعوت الفضفاضة والتعبيرات الشعرية والمصطلحات الغريبة غير المفهومة . لن تؤدي إلا إلى عزلة أكثر لهذا الأدب وتفاقم أكبر لموقفه الصعب، وعرقلة تطور الكاتب. علينا أن نتحاور كأصدقاء، لنكتشف مواقع ضعفنا ونساعد بعضنا البعض، في غيبة النقد العلمي . وهذا النقد ليس منافسية وصراعاً لتدمير الوحدة الأدبية، بل هو لتعميقها، واكتشاف مواقعنا على نحو أفضل وتوجيه كلماتنا للتأثير المشترك في الواقع.
سوف نناقش هذه المجموعة من زاويتين، الزاوية الأولى هي زاوية البناء ومدى قدرة الكاتب على خلق بناء قصصي متماسك. ولا يعني هنا أن الرؤية المتجسدة في هذه الأعمال ــ سواء المتماسكة أم الضعيفة ــ إيجابية، فقط أننا بتركيزنا على هذا الجانب نستطلع جوانب التشكيل المختلفة حتى نعثر على جوانب الخلل التي تقودنا الى خلفية هذا التشكيل وأسباب جفافه وضعفه. الزاوية الثانية هي زاوية الرؤية أو تناقضها، هذه الرؤية التي تؤدي إلى التشكيل بهذه الصورة. أي أننا ننتقل من الشكل إلى المضمون ونرى علاقة التأثير بينهما.
بين التداعيات والقصة القصيرة:
العديد من قصص المجموعة عبارة عن صور متناثرة لم يستطع الكاتب أن يخلق المعيار الفني الذي يوحدها ويعطيها الدلالات المبتغاة. انها تداعيات ربما وحدتها أحاسيس ما، لكن لم تأخذ فرصة النضوج الكافية للتبلور في هيكل حدثي متناسق، فانطلقت الصور المقطوعة؛ والتعبيرات المباشرة في كل اتجاه.
أن التداعي والانطباعات حينما تتحول الى انطلاق عفوي، لا تضبطها الهندسة الفكرية يتبعثر المحور الذي يربط كل الجزئيات ويوحدها . ليست المسألة مسألة التخطيط والمنطق الحسابي، ولكن ذاك التفاعل الخلاق بين الوعي والعفوية، بين المنطق والتدفق.
سوف ننتقل مباشرة من النظرية الى التطبيق .
في (انفعالات طفل محاصر) نجد عشرات الصور المبعثرة والتداعيات لكن لا نجد هيكلا حدثياً نامياً .
في البدء تطالعنا صورة الراوي والفتاة التي تجلس قربه . ليس بينهما وبين البحر سوى جداد سميك . بينهما حب ولكنه حب خارج على القانون، وهو حب سخي، تلاحقه معاطف المخبرين و . . . و. . . يخرجان من المقهى، يستلهمان الماضي والمستقبل، وكانا مأخوذين بسحر العرائس، ولكن يعود الحصار فجأة ويعود الجدار السميك .
ثم ننتقل إلى صورة أخرى، لا تأتي كتوليفة وتركيب؛ بل كقطع في البناء. فثمة غرفة موصدة وخالية إلا من طائرات تقذف قنابلها في لحظات خاطفة، نجد عيناً في الأرض وأخرى في الرأس . الطفل المحاصر يحصي أصابعه فيجدها سبعة .
الصور الثانية جاءت ولم تحدث تركيباً بنيوياً، انفصلت عن الصورة الأخرى؛ وتأتي الصورة الثالثة أولا كأقوال تقريرية (أعشق الريح والخليج والوقت الآتي والرمل والبحر والمراكب)، تقريرية لأنها لم تتجسد تصويرياً، فنحن نبغي الخليج ولكن أين هو؟ وهذه الانفلاتات التقريرية تأتي لتزيد الفصل بين الصور، وليس لها من قيمة بنائية . والكاتب مولع بهذه الجمل غير القصصية وهي جزء من حالة عدم النضوج الفني للقصة.
ثم نرى امرأة أيضاً. تبقى بذات الحالة التجريدية الأولى . ( ساعدها ثمرة شهية لها طلعة بهية يعشقها كل الأطفال )، الكاتب لا يبني، يبقى بحالة التداعي الأولى، لا يطور من هذه المرأة، لا يجسدها بشكل خاص وحميمي، لكي يحولها من أوصاف عامة تنطبق على أشياء كثيرة إلى إنسان ذي ملامح . اللغة الناعمة الملمس المنتقاة، تقيده . لا ينتقل إلى الإنسان، إلى تركيب صورة تكشف أعماقه .
يقفز إلى الملهى الليلي ويدع تقريريته تتحدث . فهو يمقت الرقص الشرقي في العلب الليلية وامتهان الأجساد ويكره مدير الملهى واللوطيين والمخصيين وأصحاب المصارف . لقد جاءت هذه الصورة أيضاً بلا توليف، فلا تطور جانباً حدثياً سابقاً . بل تنقلنا إلى أشخاص جداد وموقع جديد مضيعة الفرصة للتركيز على الأشخاص السابقين . إن هذا الانتقال لا يضيف فنياً أي شيء . ويمكن الانتقال أيضاً إلى أصحاب المزارع والقصور والقضاة وغيرهم ولكن ما فائدة ذلك بنائياً؟
النقلة الأخرى الى شخصية ( أبي ذر). ودائماً تكون الأوصاف العامة ذات الرنين الشعري، كدقات الطبل، هي المدخل إلى الشخصية أو الحدث . أنه لا يدخل لها ببساطة، لأنه يكره أن ينزل إلى الملموس والعادي، فلغته يجت أن تكون محلقة، مجردة، فهي عبء يعانيه، وليست أداة تساعده لخلق الشخصيات والأفكار .
أبوذر يرسم وطناً دامعاً ويكاتب عالماً مجرداً هو الوطن والأمهات . إن هذه المكاتبة لا قيمة لها، تبقى شعاراً، لأنه لا بد من أم ما، خاصة؛ تتم إليها المكاتية. عندئذ مع وجه ذي قسمات معينة تتشكل علاقة حدثية قصصية، والعلاقة لها شروط أيضاً . أهم هذه الشروط صلتها بالصور السابقة وتناميها في الصور اللاحقة. فالمسألة ليست اعتباطية فثمة قوانين للأبداع.
وأبوذر يطبع قبلة على جبين فتاة كانت تزوده خلسة . ولكنها تختفي . انه يصورها كعادته مركزاً على تعبير (المطر المالح) لا الانسان الرائع .
أبوذر يدخل هكذا بلا مقدمات . الصور الأولى لم تشيده، عبارة عن كلمات لم تتآزر وتتشكل في بناء عضوي . والإحساس بالاضطهاد أو الحصار لا يشكل هيكلا . فكل صورة لها قيمة في ذاتها، وليس في العلاقة بينها، والعيب هو في هذه الصورة لأنها مبنية بشكل «ميتافيزيقي»، أعني أنها منفصلة وساكنة، وليست جدلية؛ مرتبطة ببعضها البعض، مؤثرة ومتأثرة، خالقة بذلك لوحة عامة.
وفي المقطع الخامس نقرأ مانشيتات إخبارية لا علاقة لها بالصور والبناء السابق . إن الحديث عن الشهداء والاعتقال لا يكفي ليشكل قصة فما بالك بقصة ثورية، في ضوء عدم الاهتمام بالتكنيك القصصي أولا ؟
وتكملة لهذا المقطع نعثر على صورة . يصادف الراوي قاطع طريق . القاطع يقدم أكلا قليلا، وكان كلاهما جائعين؛ فلم يشبعا . تحدث عن نفسه فأوضح أنه يحارب عصابه احتكرت مياه الشرب عن الأهالي، فيسلب مواشيها وعربات المياه، ثم يوزعها على الناس . وهو منكر لذاته أيضاً، فيراوغ عن قول اسمه .
هذه صورة لا علاقة لها بالحدث أيضاً . وسندرس في جانب آخر دلالة قاطع الطريق هذا.
أما في المقطع السادس فيخرج الكاتب عن الموضوع تماماً . يصور لنا حكاية رجل يبيع ذراعه الوحيدة بعشرة فروش . ان من الممكن كتابة عشرات المقاطع مثل هذه ولكن ما وظيفتها ؟ ما الإضافات التي تقدمها للبناء ؟
وفي المقطع السابع نقرأ نداءات متكررة الى المرأة المطهمة بالنار والماء . وهي بلا قيمة فنية، وتبدأ الصورة حين تزمجر الذئاب في وجه أبي ذر، وهو ممدد ومقيد على الأرض . الدماء تغادر جسمة والذئاب تلحس ما تبقى .
ولا يطور هذه الصورة بل ينطلق في تداعياته وانثيالاته، يرتفع ويتوغل في الوقت، ويمضي معه .
وفي المقطع الثامن استمرار لهذه التداعيات . الجمل الناعمة، الشاعرية، لكن قصصياً، الفارغة .
وفي المقطع الثامن يصل أبوذر إلى موقع لا ماء فيه ولا شجر . ولكن قبل أن يكمل أو ينشىء الصورة يزوغ إلى التداعيات والاقتباسات ثانية . يكتب عن سفر الرؤيا . ولا يتم مسيرة «بطله».
نرى أن الكاتب لا يتحول إلى قصاص، يمتلك كيفية البناء القصصي، فهو لم يقم بإنضاج الفكرة/الصورة لكي تصل الى معمار محدد المعالم، فقبل أن تتشكل وتكون بناءها، أجهضها وأخرجها الى «النور» .
ولأن البناء غير مكتمل تنهمر العبارات المباشرة وترفع اللافتات، فلم تنصهر هذه الشعارات في لحمة الحدث، بل بقيت كدليل على التسرع وعدم إتقان التكنيك.
وجانب آخر من عدم الاكتمال هذا نجده كما قلنا في عزل الصور عن بعضها البعض، فالنظرة التركيبية هي وحدها التي ستحيل هذه الشظايا إلى منظومة . أن (شخصية) أبي ذر كان يمكن أن تتحول إلى محور، فتتجمع حولها كل الجزئيات غير المنجذبة إلى مركز .
إن الكاتب أضاع الشخصية من التاريخ والواقع المعاصر . لأنه بكل بساطة لم يرسم شخصية . فهو لم يجهد نفسه تكنيكياً من أجل خلق هذه الشخصية، واستساغ لعبة التداعيات والأجزاء المبعثرة والجمل الشاعرية؛ ونسي واجبه كخالق للشخصية، فتلاشت الشخصية والقصة والشعر معاً .
اللغة الجميلة البعيدة عن اليومي لها دور في الاتجاه إلى التجريد، فالكلمات تتدافع بقانونها المستقل غير موظفة لبناء الحدث، وحينئذ تفرض شروطها عليه . هي تبقى كغاية؛ بدلا من أن يكون الحفاظ على جمالها يأتي بالدرجة الأولى من خلال دورها ووظيفتها في البناء .
ــ (العواء) أيضاً عجزت عن التشكل كقصة . ثمة بطل يوحد الصور المبعثرة، وهو الراوي، وهذا التوحيد ليس المعمار المطلوب، فهذا الراوي لا يختلف عن صوت المؤلف . فكأن الكاتب يفكر ويحلم و يمشي .
نرى أولا صورة المقهى، يبدأ الكاتب كالعادة بعبارات كبيرة، فلا يخلق حدثاً منذ أول كلمة، بل يفتتح المشهد بأبهة الكلمات الفخمة ( توقفنا عند حدود الكلمات المنطوقة والمهربة). ( لنكتشف لغة أخرى بلون أحداق الشمس) .
رواد المقهى أجادوا لغة الكلام فصمتوا . لذا يقرأ أحدهم ملصقاً سرياً . ثم يقفز كهل ويقوم برقصة عنيفة تمثل بدوياً أنهكه البحث عن خيمة وعشب .
خيبة الراوي تتجلى في الشارع البارد أيضاً . يطارده عواء فيفزع ويجري. تحتويه الغرف الخالية . ليس فيها سوى ذكرى حبيبة، وهي ليست حبيبة حقيقية بل مجرد نداءات تطلق الى شيء غير محدد بالمرة . فالمرأة لدى الكاتب ــ عبارة جميلة وليست انساناً ــ عنصر المرأة لا يتضافر مع الصورة السابقة لكي تنمو حدثياً، بل هي تداعيات يجمعها إحساس بالضجر والخواء .
الصورة الأخرى التالية تشكل نمواً؛ وهي صورة الصديق الذي قرأ الملصق وهو ملقى في سرداب قذر تمزقه الطعنات . وهذا النمو تجسيد لبشاعة الواقع المحيط بالبطل وليس أكثر من ذلك . بمعنى أنه لا يتشكل مع المرأة والبطل ليشكل علاقة قصصية . وبدلا من هذا التشكيل ينطلق في حديث مباشر لغيمة «ثورية». حديث غير عضوي، مجرد استطراد للملصق .
و بشكل مفاجئ يدخل الجنود أيضاً مسرح التداعي . تحدث مجزرة فيأتي صوت من بعيد هو العواء . لم يكن تردده سابقاً إلا إيذاناً بمجيئه هذه المرة ولكن بشكله المجسم في هيئة جنود وعلى شكل أسلحة . وهذا الصوت ليس وحده، فثمة صوت آخر ؛ هو الأغنية . اللغة المضادة للعنف .
يرقد الراوي، هناك أصابع خشنة تتجول في جسده وجروحه .
مقطع الحوار التالي يدل على تغير موقف الراوي، على انتقاله إلى الغناء، ولكن بغموض؛ فليس ثمة تغلغل في نفسه؛ أو كشف للابن الذي يخاطبه، عبارات مبهمة لا تروي شيئاً .
أما النداء الأخير الى المرأة/العبارة فيكشف موت الراوية أو استشهاده، وذلك سيان .
إن هذه الصورة الباهتة، التي تفتقد إلى الحرارة العاطفية والتشكيل المتفجر حيوية، لا تشكل قصة . إن الصراع بين هؤلاء الأشباح والمضطهدين نراه في قصص عديدة، ولكنه ليس مشجباً يعلق عليه الكاتب كسله الفني، لا بد من تشكيل بنية ذات علاقة عميقة، تميز هذه القصة عن تلك، تخلق أبطالا لهم شيء محدد خصوصي، يعطيهم نكهة، ويعطي علاقتهم مناخاً متميزاً .
لكن الكاتب ينثر تداعياته، مقهى، امرأة، غيمة، جنود، منزل، غير قادر على خلق علاقة حدثية بين هذه العناصر . مضيفاً إلى هذا التبعثر جواً مجرداً يعمق هذا التبعثر.
ــ قصة (ولم ينته هذا الحلم البلوري) تختلف بعض الشيء عن المحاولتين السابقتين؛ فالمجموعة المتناثرة من الصور نجد أنها تتألف وتتضافر حول البطل وهو الرجل البرجوازي وخادمته . هذا الرجل وهذه المرأة يؤلفان نقيضين، أي قطبين متنافرين في الصراع الاجتماعي . ومن خلال «شخصيتيهما» ومن خلال الصراع بينهما ينمو المحور ويتشكل .
هو رجل مذعور ووحيد في منزله . وهي امرأة تعمل وتقرأ . في انطلاقة المذعور من البيت يقابل (صديقه) وزوجته. وحين يشتهي المرأة لا يتردد بينما يقف الصديق مغطياً عينيه المفتوحتين . ولكن حين يشتهى الخادمة ترفض وتقاوم.
هذه هي العلاقة المحورية لدينا، الرجل رغم كثرة المقاطع عنه ظل غريباً، بعيداً مجرد رمز ك/ س/ مثلا، وهو رجل بملامح غربية . فهو لم يتشكل بمناخنا وتربتنا الوطنية، تشكل من قراءات القاص، ليس كنتاج للواقع المحلي، والخادمة أيضاً هي رمز لا شك أنها تتمتع بمزية المقاومة، ولكن لم تخرج عن كونها شيئاً مجرداً، وليست إنسانة، فنبع البطلين واحد.
لن نناقش الأسباب الفكرية وراء هذه الظاهرة الآن، بل سنقتصر على رؤية التشكيل . وبهذا الصدد نقول: إن العلاقة الرئيسية لم يمعمقها الكاتب نفسياً واجتماعياً. لم يركز على ذات البطل لينتزع ملامحها وخصائصها الجوهرية، وليكشف من ثم أساسها الاجتماعي؛ ليتشكل البطل كشخصية حيه ــ وكذلك البطلة . إن الكاتب لا يزال يبعثر أجزاء القصة، غير قادر على لحم الأجزاء بمهارة . وبدلا من إتقان التكنيك يلخص بعض قراءاته وينثرها في القصة . فهنا مقتطع من سيناريو وهناك مقطع من قصيدة لشاعر فرنسي وأيضاً مشهد من فيلم ! هذه «التوظيفات» لا قيمة لها على الإطلاق . لأنها لا تضيف شيئاً لتعميق رؤيتنا للشخصية أو لتطور الحدث بالإضافة إلى أن ثمة صوراً أخرى لا تقوم بهذه الوظيفة أيضاً، رغم صلتها بالحدث . كأمثلة : منظر المصنع؛ المحكمة، الجنود . هذه كلها تدلل على أن الكاتب لا يختار الزوايا الهامة والدقيقة لاكتشاف شخصياته، لأن رؤيته لا تتركز على (الإنسان) بالدرجة الأولى .
ــ (ايزادورا . . دعوة للمشاركة)، هذه ليست قصة، ثمة امرأة راقصة ذات اسم معروف، لكننا نجهلها في الحقيقة. لم يصهرها القاص في حدث ساخن؛ فنرى أعماقها وطبقتها الاجتماعية وصراعها. الصورة عبارة عن منظرين صغيرين لا أبعاد لهما. الرجل الغربي البرجوازي في القصة السابقة تحل مكانه امرأة غربية. وليس ثمة صدى لواقعنا، فنحن ضيوف غرباء على المنظر .
المرأة لا تفعل شيئاً سوى أن تتعرى وترقص تحت رذاذ المطر، ثم يلقى القبض عليها قبل أن يحضنها حبيبها.
هذه الصورة قطعت إلى ثلاثة مشاهد، وهناك أيضاً استشهاد بأحد أقوال راقصة عاصرت ايزادورا ولحسن الحظ وضع الاستشهاد خارج القصة هذه المرة . تقطيع الصورة الصغيرة الى ثلاثة مشاهد ترينا سيطرة الشكل على وعي الكاتب . الفكرة ظلت باهتة، لكن الشكل ظل يتمتع بالاهتمام الأول .
ــ يصل الكاتب في العديد من القصص إلى التماسك الشكلي، فتتشكل عضوية موحدة، وتتآزر العناصر المختلفة لتبلور فكرة .
في (النافذة) تبقى ملامح الصراع ذاتها. الخادمة هي المرأة المضطهدة التي تعاني يومياً شراسة السيد ووقاحته. تفتح النافذة فيستقبلها الهواء ويدعوها للطيران . والطفل يضحك أمامها فتحاول أن تقلده فلا تستطيع، والنهر يدعوها لتتعلم الكفاح فلا تقدر أن تفعل شيئاً، ويبقى السيد سيداً وتبقى الخادمة عبدة . . وتغلق النافذة.
هنا ليس ثمة شيء زائد، كافة العناصر البشرية والطبيعية تؤدي دورها في انسجام عضوي، ولكن هناك أشياء ناقصة . يتضح في القصة دور العوامل الطبيعية كالهواء والنهر في إعطاء المرأة صورة أخرى لوضعها من أجل أن تغيره . أيضاً (الطفل) وهو عنصر رومانسي في أدب أمين، يومئ لها نحو الطريق ولكنها عاجزة عن الضحك والسير . إن هذه العوامل تتشكل كرموز، وليس كعلاقات بشرية مع المرأة . القاص يقطع صلتها بالناس، بالحياة الاجتماعية الغنية، ويترك لها علاقة شاحبة مجردة؛ وعليها أن تثور من خلالها. أن اضاءة تاريخها بشكل ومضات سريعة، ووضعها في إطارها الاجتماعي، قد يكشف محدودية قدراتها للتطور؛ وقد يفتح لها أفاقاً جديدة .
القاص بوضعه «البشر» في ثلاجات يريدهم أن يزخروا بالنار . فقط في حالة ذوبان الجليد واكتشاف الكاتب للمناطق الحارة في منطقتنا، سوف تتشكل نفسية حية لهؤلاء الشخصيات المطمورة بذاك التشكيل المدمر لقدراتهم وإمكاناتهم .
ــ ملاحظات صغيرة :
نستطيع أن نحدد ملاحظات أخرى على التشكيل نكمل بها الصورة :
أولا : هناك تباين بين عنصرين مختلفين وهما عنصرا التجريد والمباشرة . فبقطع جذور الشخصيات عن واقعها الملموس، وافراغها من محتواها الاجتماعي، يتضاءل التوجه الثوري للعمل الأدبي وتضعف مهمته التحريضية، فتظهر العبارات المباشرة تعوضاً عن نقص في البناء والتوصيل.
ثانياً : الاهتمام بالشعر والسينما يأتي ضد القصة، فهذان الفنان لا يندغمان في التكنيك القصصي، بل يظلان طافحين فوق السطح، ولهذا يكون لهما أثر مدمر على التشكيل القصصي، أن أي وسائل تستخدم يجب أن تساعد الشخصية والحدث في التكون والتطور وأن تذوب في الهيكل العام للقصة لا أن تكون مفردات طافية على وجه القصة .
ثالثاً : ثمة تناقض في هذه القصص، وهو التناقض بين «الحالة الشعرية» والوعي «الموضوعي» الذي تتطلبه الكتابة القصصية، فتلك الحالة تعطي غنائية ونطلاقاً غير مخطط الصور؛ وهذا الوعي يتطلب تخطيطاً وبناء فكرياً لخلق شخصيات في حركة وفعل . والقاص حينما يثبت قدماً في القصة وقدماً أخرى في الشعر تختلط الحالتين في عمله، فلا يكون قصة أو قصيدة .
رابعاً : الكاتب في محاولته للوصول إلى العام والجوهري يخفق تماماً، لأنه يضع طريق الوصول اليه دون المرور بالملموس والثانوي .
إن تصوير الحدث والشخصية بعمومية وإطلاق يؤدي إلى عدم واقعيتها، أن الواقعية تتطلب مزجاً بين الملموس والمجرد، بين الثانوي والجوهري، وبدون هذا المزج نتحول الى مدرسة أخرى .
ــ المناخ الغربي :
قاد تجريد الشخصيات والأحداث من واقعها المحلي والعربي، الكاتب إلى سيطرة أجواء قراءاته ومشاهداته لنتاج الثقافة الغربية . كان التصور السابق أن القاص بقطع الجذور الاجتماعية والوطنية لكائناته الفنية انه يجعلها مطلقة، مجردة، غير محددة الجهات، ولكن اتضح أن ثمة واقعاً آخر يجذبها ويجعلها تدور في فلكه، فغدت هذه الكائنات تعيش في أجواء غربية . فانقطعت عن واقعها الذي تستمد منه الماء والضوء .
ستتناول عناصر مختلفة لرؤية هذا المناخ .
ــ (هنالك امرأة تطل من الشرفة وترمق البحارة الذين يتزاحمون داخل وخارج الحانة . . ص 5)
ــ (. . ومدير الملهى يفتح زجاجة الشمبانيا في تخب زوجته التي تعاقر اللوطيين والمخصيين وأصحاب المصارف جهراً . ص 13).
ــ كان بضعة رجال يرتدون ملابس عسكرية غريبة؛ منهمكين في صنع صليب خشبي ص 33).
ــ ( الغرفة خالية ، بدون أثاث أو لوحات عصرية أو تماثيل افريقية ص 42).
ــ (عارية ورذاذ المطر يداعبها ويعانقها).
ــ ( ضباب شفاف يدور حولي . امرأة بيضاء قادمة نحوي . ص 50).
ليست المسألة مسألة كلمات مثل «الحانة»، «الصليب» ، «التماثيل الافريقية» فحسب، ولكنه جو شامل يغطي معظم مساحة المجموعة . المرأة في قصة «الفراشات» تظل بلا نكهة شعبية، فهي ترمق بحارة في حانة ذات مواصفات غربية . تظل المرأة باهتة وغريبة، ليس لأنه مسخ شخصيتها فحسب، بل لأنه وضعها في مناخ غير مناخها . لم تلتهب بنار أرضنا، رغم أن زوجها سجين، ظلت في غرفتها الباردة وشرفتها البعيدة ولم تر حاراتنا وحاناتنا . هذا الجو الناعم الغربي جعلها غير واقعية فماتت .
البطل البرجوازي في (ولم ينته هذا الحلم البلوري) هو من قراءات القاص وتأثراته بالثقافة الغربية، فهذه الشخصية لا يجمعها جامع باناسنا، حيث أن الكاتب شكلها في جو غربي صرف . علاقته بالخادمة، واقع السهرة، لقطة الفيلم الفرنسي، مضاجعته للزوجة أمام زوجها، منظر المحكمة ووجود عنصر المحلفين، مقطع من قصيدة لشاعر فرنسي . هذه العناصر المتعددة «تغرب» الموضوع والحدث . إضافة الى عنصر التجريد المتفاعل معها، فهذا كله يساهم في إخراج القصة من التربة المحلية .
مناخ القصص يميل عادة إلى البرودة، والمطر ليس قليلا؛ أما الصيف والحرارة الشديدة ــ وهي السمة الغالبة في مناخنا ــ فقلما نعثر لها على أثر .
والشخصيات هي مثل و«تجنسكي» و«ايزادورا» حيث البروز الأكثر وضوحاً لسيطرة القراءة لا الواقع، وسيطرة موضوعات لا تمثل هاجساً لإنساننا . تتلاشى ملامح الخليج بتراثه ورجاله ونسائه ونضاله وأجوائه، لا أثر للزنج والغواصين وعمال البترول . بل هي وجوه شاحبة وخطوط مجردة وأجواء غربية .
ــ الموقف المأزوم :
أن تأثر الكاتب بالثقافة الغربية ليس الا تأثراً بمواقف معينة في هذه الثقافة، وهي تلك المواقف المأزومة ذات التوجه البرجوازي والبرجوازي الصغير .
في (نجنسكي . . حنجرة الرعد) نكتشف بعض جوانب هذا الوقف .
نجنسكي يرقص رقصة الحرب . يمثلها بحركة جسده . اللغة الشفافة تمثل الحركة الخارجية وسطح الموقف. نجنسكي يركض وينزف ملحاً . يغادر نجنسكي خندقاً ــ قبراً إلى خندق ــ قبر آخر . ثمة جنود وضباط يخطبون بحماس وقتلى .
القاص صور ساحة حرب، ولكن لم يتغلغل إلى أية أبعاد اجتماعية وراءها. فبالنسبة إليه يقف المعتدي والمعتدى عليه على صعيد واحد . المناضل كالفاشي، لا فرق، هي مجرد حرب لا أبعاد لها . الراقص، والكاتب؛ ضد هذه المجزرة ولكن من سببها ؟ وما هي أسبابها ؟ أنه لا يجيب، فقط يتعرى، متخلياً عن توجيه الاتهام الى عدو محدد ، متجهاً الى لعن الزيف ومن أجل البراءة . هذا الموقف الهروبي يتستر بالمجردات، فيبدأ درجة درجة صاعداً نحو الجنون والانفصال عن الواقع والبشر .
تجاه الحرب يرقص عارياً، وتجاه متعهد حفلاته يغمغم في ذاته . ليس لديه موقف حقيقي تجاه الإثنين، وفي هذا الفراغ المرعب وانعدام الوعي للنضال ضد الشرور الاجتماعية وخالقيها يفتح له الكاتب باباً عريضاً وهو باب الصوفية تجليه الأول من خلال الرعد الذي يبحث عن حنجرة له . أنه لا يصل إلى حالة فقدان العقل حتى يتحد في هذه اللحظة، بل يستمر في تحديه للناس . الصالة غاصة بالجمهور وهو واقف كالتمثال لمدة نصف ساعة . ثم أخذ ينزع ملابسه قطعة قطعة. الجمهور ينسحب . زوجته تبكي، فلا يجد الا الطفلة يراقصها. يتمنى أن يظل الأطفال أطفالا حتى الممات، معبراً بهذا عن فشله وأزمة طريقه .
ويتعمق بهذا طريق الصوفية والجنون . ولا يصور القاص هذا الطريق كأزمة بل كتطور خطير وعملقة للبطل . أن الله نار في رأسه !!
نبذه الناس فانطلق في الهواء والفراغ فاحترق والتقى بالرعد حنجرته . الكاتب حول الأزمة إلى موقف عظيم والانهيار الى تألق، والهروب الى بطولة .
وعوضاً عن كشف موقف نجنسكي وجذوره الاجتماعية الضاربة في تربة طبقية قلقة، يقوم بوضع أكاليل الغار على هذا الانحدار .
لغة الشعر المستخدمة والتمثيل الصامت والعناوين الجانبية والأقواس كلها عجزت أن تحول هذه الصور الي عمل حي رائع . لأنها ارتكزت على موقف طمس القضايا الحقيقية لتمجيد بطل فردي لا يمتلك أياً من مميزات البطولة .
ولكن ليس هذا وحده مما يشكل موقف الكاتب فهناك جوانب أخرى فيه . في قصة (انفعالات طفل محاصر) رأينا وجود قاطع طريق . انه ليس قاطع طريق حقيقة بل هو شخص متمرد على امتيازات الأغنياء واستغلالهم . يعطي البطل جزءاً من طعامه القليل ويكشف له عن مهنته . وهي أنه يحارب عصابات من الأغنياء احتكرت مياه الشرب عن الأهالي فيسلب مواشيها وعرباتها المحملة بالماء ثم يقوم بتوزيعها على الأهالي . وحين سأله عن اسمه راوغ وتحدث عن الحصاد وأغاني الراعيات ورؤيا الأنبياء.
هذه «الشخصية» تمثل إضافات أخرى إلى نجنسكي، فإذا كان ذاك في موقف غائم ضد المعسكرين المتصارعين دون وعي عميق، فإن هذا يقف بشكل أكثر وضوحاً وتطوراً ولكن بطريقة تمردية وفردية . وتختلط في وعيه الاحلام الجميلة والمشاعر الدينية . وهو بهذا نموذج آخر لذات التركيبة الاجتماعية .
في (هذا فرحي . . اغتالوه وهو طائر) نجد صوراً عديدة وكلاماً إنشائياً ولكن لا نعثر على قصة، البطل يحلم وهو في المهد بأنه طائر يقطف نهود جنيات البحر؛ ولكن الواقع يؤكد لغة أخرى، فبين المقهى والمقهى قتيل جائع؛ ومقصلة تمضغ رأس طفلة . انه شخص مأزوم، نفسيته تضطرب بين الرفض والاستسلام . والكاتب لا يصور هذه الأزمة ويبينها في حدث متكامل بل هو كالبطل لا يستطيع أن ينضج أزمة بطله، ويعرضها من خلال معادل ما، بل يلقيها وهي في حالة الاجهاض هذه .
وتتحول هذه الأزمة في كلمات خاطفة إلى صرخات ومحاولات للقضاء على الصحراء المحتضنة للأعداء والسجون والكلاب ومؤسسات الإبادة . الآن يعود حاملا بندقيته مع رفاقه ليعلن الغزو . في لحظة أخرى نراه يبحث عن لبن الأم . لم يجد سوى ملصقات واعلانات . الأم ، المرأة ، كانت مسجونة في قفص وأحياناً يعرضونها في السيرك وفي البرلمانات . قال الصديق : العنف باب الأبجدية . تبقى المسافة بينه بين الصحراء وتغدو الأم قتيلة .
إذا كان نجنسكي ضد الحروب بشكل مطلق . فهذا البطل في قصتنا هذه مع العنف بشكل مطلق، انه ينزل إلى المدينة مع رفاقه معلنين بدء الغزو ولكن لا يتم من ذلك شيء . ليس ثمة عمل صغير يعملة، في ضوء هذا الحصار الشكلي الذي قيد فيه .
إن هذا التناقض في الموقف بسبب اضطراب الرؤية وانعدام الانسجام في أساسها الاجتماعي . وهذا الاضطراب لا نلاحظه فقط في الرؤية الفكرية بل وفي التشكيل الفني أيضاً . حيث الاضطراب في البناء وبروز الخلفية السينمائية والشكلية .
الاضطراب في المضمون يقود إلى الاضطراب في الشكل . فالقاص بملاحقته البعيدة لواقع غير واقعه يشحب المضمون الفكري لعمله، فيصاب بالجفاف، فلا يبقى سوى ملاحقة الأشكال الجديدة، مع الرغبة الدائمة غير المجدية لتحطيم استقلالية الأنواع الأدبية، هذا كله يؤدي إلى أزمة العمل ككل .
الرجوع الى الينابيع؛ الى الوطن والناس، برؤية تبحث عن علاقاته وبشره، مع الاستفادة من التكنيك الجديد للتغلغل أكثر في الحياة والارتباط أكثر بصناع الحياة الحقيقيين لا الوهميين، هذه فحسب تضع الشروط الأساسية لحل التناقض بين الشكل والمضمون في أدب القاص .
ــ نلاحظ الأثر السيء للأسلوب في قصة (ارتجافات عناقيد الماء في الهواء)، القصة متماسكة، صورها تخلق أثراً هاماً موحداً؛ والكاتب يوظف حادثة أسماء وابنها عبدالله بن الزبير التاريخية ليعطيها دلالات جديدة معاصرة ومضيئة .
يقترب من خلق «أسماء» كشخصية حية ولكنه يتوقف في منتصف الطريق، فالأسلوب ببلاغته الشعرية يجعله على سطح الشخصية والموقف، تجذبه الصور الجميلة فتتولد من البحر الجنيات والزنابق بينما لا تلد الشخصية شيئاً . الصور لم تساهم في التغلغل في الذات، وهنا يقيد الشكل المضمون ويكبحه .
الكاتب يبتعد في أحيان عديدة عن التجريدات فيصور أسماء كامرأة عادية تنشر الغسيل وتشتري الخبز وعبدالله كعامل يضرب مع المضربين . وللأسف فهذا الصعود الحقيقي إلى الشخصية يضيع في غمرة عبادة الجملة ذات الرنين الموسيقي، وبسبب التوجه المباشر أيضاً. أخذنا مونولوج عبدالله تحت سقف الحانة كمثال، فماذا سنجد ؟
(نخب الانتفاضة المطعونة . في الظهر، نخب النتائج، نخب الشواطئ ، التي استهلكت بكارتها فعربدت ثم نامت مفتوحة الساقين، أضحت البنادق خنادق وفنادق نعاقر فيها خيبتنا ونضحك ملء أفواهنا رمل …).
إن هذا ليس بمونولوج فهو تعبيرات عامة واضحة ليس فيها من صور البطل الشخصية وذكرياته وتداعياته شيئاً، فيها الصدى الجميل وفيها الطرح المباشر رغم أنه لا علاقة له بالحدث . فالقضية قضية اضراب فاشل وليست انتفاضة مطعونة في الظهر . فأين هذه الانتفاضة في القصة؟ ومن طعنها ؟
بدلا من مسك الخيوط الفنية و تنمية الشخصية بأعطاء لمحات نفسية تحولها الى لحم ودم ينجرف الكاتب مع شلال الخطابة فيأسره التدفق اللغوي فيضعف التغلغل في الشخصية والواقع بالتالي .
يأخذنا للتفاعل المتبادل بين الشكل والمضمون، نرى شحوب هدف العمل الأدبي، نتيجة التجريد و«التغريب»، ولهذا تتركز اهتمامات الكاتب في تطوير الشكل، وهذا التطوير نتاج الثقافة الغربية وفنونها. وبالأخص الفرنسية، ولكن القاص في محاولاته للوصول الى مضمون أعمق، وفي لحظات اقترابه من واقعنا، يكبح الشكل الذي اعتاد عليه هذا التطور .
وهنا ضرورة وجود حلقة «كسر» لهذا الشكل . ولكن ذلك يتطلب تعميقاً للنظرة وتغييراً لاهتمامات عديدة . يتطلب عناية بالتكنيك القصصي، وكسر الجو الغربي . هذا يعني تغلغلا في الواقع المحلي، والدخول الى تاريخ المنطقة وتراثها وحكاياتها الخ . .
ان مشاكل القصة عند أمين هي ذاتها مشاكل القصة العراقية في الستينات. يقول برهان الخطيب في مقالته (الاتجاه الواقعي في القصة العراقية القصيرة) «كثير من قصاصي الستينات كان يكتب بهذه الطريقة الحرة، وهذا الأسلوب كما نرى نموذج لخضوع الكاتب لمؤثرات خارجة عن عمله، فإن مسايرة الإيقاع اللفظي هنا لا تقود إلا إلى الابتعاد عن خط الموضوعة.» _ راجع الأقلام ؛ العدد 12، 1980.
ليس هذا فحسب بل غلبة الفكرة المنتشرة في الأدب الفرنسي المعاصر وهي فكرة اتحاد النثر بالشعر، والاتجاه نحو صهر كافة الأنواع الأدبية في كل واحد، نجد صداها لدى أمين .
أن الأنواع الأدبية من الممكن أن تستفيد من بعضها البعض أما الصهر فغير ممكن ومدمر لكل الأنواع الأدبية .
ــ الحصيلة :
بعد جولتنا في هذه المجموعة ما في خلاصة الموضوع ؟
أولا ــ نرى أن العديد من القصص ما هي إلا محاولات لم تتشكل في هيكل ما . وهذا التبعثر في الصور نجده لسببين . الأول: الكاتب لم يقم بإنضاج فكرته الأولية بحيث ترسم من خلال تقنية القصة فحدثت لها عملية إجهاض . الثاني: وقوف هذه المحاولات بين الغنائية والتشكيل الموضوعي القصصي، بسبب أفكار الكاتب المتأثرة بتيارات معينة في الأدب الفرنسي .
ثانياً ــ في حالة تشكيل القصة فنياً نجد تحول شخصياتها إلى خطوط مجردة تعيش في بيئة غير بيئتنا وتتنفس هواء غير هوائنا . الكاتب لا تملكه رغبة ملحة في تجسيد تجربة شعبه وأرضه .
ثالثاً ــ بهذا يقف الكاتب على العكس من المدارس الواقعية بمختلف تشكيلاتها، فهو لا يقوم باكتشاف واقعه وقوانين تطور هذا الواقع، بل ينفصل عنه، فلا نجد «الإنسان» في قصصه لأنه ينطلق من التعالي على الواقع الذي يشكله .
رابعاً ــ تعويضاً عن افتقار المضمون إلى حرارة الواقع والحياة تتركز ابداعات القاص في استخدام وسائل تكنيكية عديدة، ومعظم هذه الاستخدامات تأتي غير مصهورة في البنية القصصية .
خامساً ــ أن ثمة تبعية في الموقف من الثقافة الغربية وعالم الكاتب الفني يحتاج إلى موقف نقدي تجاه هذه الثقافة كشرط أساسي لتطوره . وما دامت هذه التبعية ملازمة له فسيكون بعيداً عن الواقعية، سواء كانت نقدية أم اشتراكية، قديمة أم حديثة، لأن الواقعية تعني اكتشاف القوانين الموضوعية لتطور بلده وشعبه، وليس في نقل النتاج الثقافي الغربي وشكليته المتغيرة دوماً تعبيراً عن أزمة مغايرة لواقعنا وتطورنا وثقافتنا.
هذه الدراسة نشرت في مجلة الكاتب العربي العدد الرابع من السنة الاولى ديسمبر 1982 دمشق.



