الدكتور إبراهيم غلوم .. ورؤية خاصة وغريبة عن التجريب المسرحي
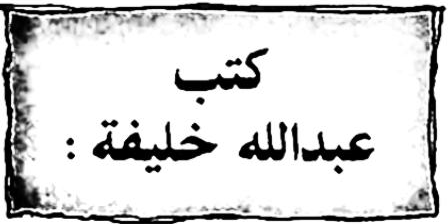
للدكتور إبراهيم غلوم مساهمات هامة في الدراسات الأدبية والنقدية والمسرح، واتجاهه لتطويرهما واكتشاف ملامحها الداخلية البعيدة. وأعماله تعتبر منعطفا في سياق دراسة الأدب في الخليج وربطه بالمناهج الحديثة.
لكنه في اتجاهه لخلق اتجاه تنظيري تجريبي في المسرح؛ يبتعد كثيراً عن تلك المنطلقات، بل وحتى عن تجربته المسرحية الوحيدة.
وقد قدم ورقة لرؤيته التنظيرية لهذا المسرح التجريبي في محافل عدة، كان آخرها ندوة أجريت عن المسرح التجريبي في البحرين. وسبق للورقة أن نشرت في جريدة الأيام. كما أنها مطبوعة بشكل خاص لدى مسرح أوال.
يبدأ د.ابراهيم غلوم ورقته «إرث مشترك، حلم جامح: عن التجريب وتداخل الثقافات»؛ بالدعوة الى ممارسة جهد عقلاني منفتح، وتقفز هذه الجملة العقلانية فوق السطور؛ بشكل دائب، داعية دوماً الى الاكتشاف والاستبصار والتفتح العقلي. غير أننا لا نعرف ما هي هذه العقلانية؛ التي تتضاءل باستمرار تحت اندفاع اللاعقلانية.
اللاعقلانية، هذه، تظهر بشكل خجول، وما تلبث ان تتصاعد حتى الذروة.. دعونا نقتطف بعض زهراتها المرة في بدء تجليها .
يقول د.غلوم بأن التاريخ المسرحي الذي يفني التجريبي عمره من أجله هو خبرة بشرية واسعة متداخلة، وهو خيال فيه صور وأفكار (البدائي منها والمتوحش. الإنساني منها والشيطاني، الموضوعي منها والذاتي، البسيط منها والمعقد) ص 1 من الورقة .
ان العقلاني السابق ذكره، يتحول هنا الى اللاعقلاني، فتغدو الأشكال البدائية من الوعى الانسانى: الخرافات والسحر الشيطاني وغيرها من ضروب الوعي القديم في العصور السالفة ــ وهي التي عبرت عن علاقة صراعية بدائية مع الكون والاشياء الغامضة حينئذ ــ هي المرتكزات الاساسية لمسرح عصري يسمى تجربيباً.
ان الدعوة الى العقلانية، راحت تتشكل بصورة مغايرة للعقل، وهنا يشعر د. غلوم بتناقض حاسم وأساسي في دعوته، فيقول إن الانفتاح (لابد أن يبرهن على عقلانيته حتى مع حالات التعلق بفكرة حالمة أو جامحة أو مجنونة حول معنى المسرح) ص 2 .
ان هذا الشعور بالتضاد الحاد بين العقلاني والميتافيزيقي، بين التجريب والظلام، بين روح المختبرات الجسدية الخلاقة والجمود؛ لا يحل، بل يتنامى.
فالتجريب المفتوح الذي يطرحه الباحث لا يلبث ان يتوجه الى خبرات (بعيدة احياناً عن أشكال المسرح كالديانات وثقافة الشعوب البدائية من خرافات وأساطير وتقاليد وطقوس ورقص وغناء .. الخ) ص 2 .
لقد عاد من جديد الوعي البدائي، بصورة أكثر قوة وتفصيلا. فتركز العقلانى فى الخرافي، وصار التجريب مفتوحاً على مخزن وحيد، هو ثقافة الشعوب البدائية، مقطوعة من سياقها الصراعي الخاص، وشرطها التاريخي، مجرجرة إلى وعينا المعاصر. ولكن ماذا سوف نستل للتجريب المسرحي من هذه الثقافة البدائية..؟
ليس ثمة برنامج ملموس، ولكن شذرات من رؤى أخرين. فالمثل «الأكثر دهشة» هو مثال انتونان أرتو (حين ترك لخياله التنبوئي أن يكتشف من مجرد النظر في لوحة تشكيلية لرسام بدائي ما يجب أن يكون عليه المعنى الحقيقي للمسرح) ص 2.
هكذا يغدو التجريب المسرحي متعلقا بنظرة ألقاها أرتو على لوحة فنان يسميه «بدائياً». ولكن مسلسل اعتراف أرتو يكشف أنه ليس فناناً بدائياً بل مسيحياً .. فهو يقول ــ أي أرتوــ بعدئذ حسب مقتطف غلوم (أطلق ذلك الرسام على اللوحة اسم لوط وبناته.. وهذه اللوحة مثال غريب للاستنتاجات الصوفية..) ص 2.
ان العالم البدائي، يختلف عن العصور الوسطى الاقطاعية الدينية؛ ولكن ارتو في خطأه اللغوي ــ التاريخي، واستدلاله للتطور المتنوع للبشرية، في مظهر وحيد هو الوعي الديني ــ الصوفي؛ لن يرى أية فروق مادام هذا الوعي الصوفي، المقطوع الصلة بتكويناته الاجتماعية التاريخية، هو المهيمن سواء كان «بدائياً» أم «مسيحياً اقطاعياً» منقطعاً عن الحياة، متحولاً إلى نفثة سحرية. وعلينا ان نعرف ان هذا الرسام، الذي على التجريب المسرحي أن يبدأ من نفثته، هو قبل عصر التنوير والثورة الصناعية، أي ينبغي إلغاء التيارات التنويرية العقلانية الديمقراطية، والعودة الى ما قبل تشكلها، الى العصور الوسطى، الى الحياة البدائية، الى السحر !
من هذه النفثة السحرية؛ الطقسية، الاسطورية؛ البدائية، الغامضة؛ على التجريب المسرحي أن يبدأ؛ ولم ذلك؟ لم الانحصار في الغيب المقطوع الصلة بالهموم البشرية. بالآمال القومية، بالتغيير؟!
بالنسبة لآرتو ــ في السياق الذي وضعه فيه غلوم ــ وعالمه الراسمالي المهيمن على البشرية؛ النازف منها الدم والعظم، ستغدو هذه التجريبية الصوفية؛ لعبة لمثقفين ليست أمامهم قضايا ساخنة. عزلوا المسرح عن الحياة، وقطعوا شرايينه، واستلوا شرياناً واحداً يغيب كل شيء، وبحثوا في تاريخ البشر الآخرين، عن لحظات غيبية صوفية، تؤكد انغلاقهم الذاتي، كما تؤبد الشعوب الأخرى «البدائية» في لحظاتها الغيبية الصوفية، وبالتالي تستمر لعبة النازف والمنزوف.
ومن هنا يؤكد د.غلوم، على أهمية أن يتحد «العقل التجريبي» العربي مع «العقل التجريبي الأوربي»؛ ولكن ليس التجريبي العلمي، بل الصوفيٍ الغيبي.
ومن هنا كان من البدهي أن يلغي هذا العقل الفروق العرقية والقومية وأن يقف ضد أشكال التمييز العنصري وأن ينتصر لثقافة الشعوب الفقيرة والبدائية.. والا يجد امكانية اكتشاف لغة المسرح الخاصة أو شكله في تكنولوجيا ثقافة الغرب بقدر ما يجدها في ثقافة الشعوب المعزولة) ص 3.
هنا يتحد العقل التجريبي العربي الصوفي؛ المضاد للعقلانية، بالعقل التجريبي «الصوفي الأوربي»؛ في لحظة شيخوخته العقلية ــ الفنية، عائدين الى السحر والبدائية رافضين الاثنين معاً تكنولوجيا الغرب الصناعي المتقدم الديمقراطى، راجعين الى ثقافة الشعوب «المعزولة» لا المنفتحة، البدائية، لا العصرية، هروباً من اسئلة الموقف، وابتعاداً عن دفع ضريبة الفعل الثقافي النقدي.
الانفتاح هو التوجه الى الصوفية، برأي غلوم، والانغلاق هو السير نحو العلم، واذا اردنا ان نؤسس تجريبا إبداعيا مسرحيا، فعلينا أن نفارق عزلتنا «المحلية» و«القومية» وقضايانا المصيرية، لنتحد بتلك الومضة الصوفية عند آرتو في ذلك الوعي الصوفي الإلهامي عند الرسام القروسطي فهناك يوجد الانفتاح والعقل والبشرية المتألفة !
و تتنامى هذه البذرة وضوحا وتناقضا متزايدا، حين تصل بعدئذ الى تجليها الفكري، حين تسفر عن وجهها الايدلوجي، بوضوح. لماذا؟
(لان التجريب انحياز خالص لمعنى المسرح وتنحية مطلقة لاي انحياز ايدلوجي أو عرقي أم اقليمي مسبق). ص 5.
حين يكون التجريب الأوربي انحيازا للصوفية، للوعي البدائي المنقطع عن جذور عصره، سيكون (انحيازا خالصا لمعنى المسرح)، لكن حين يكون التجريب العربي انحيازا لقضايا الامة العربية المستعبدة، المقهورة، المتخلفة، واسئلة لاثارة وعيها وحركتها فسوف يكون انحيازا ايدلوجيا مرفوضا.
فالجمع بين التجريب المسرحي، وإشعال وعي الأمة، هو أمر غير ممكن في عرف د.غلوم، والانفتاح والعقلانية هو في الطلاق بينهما.
إن التجريب هنا يتحول طبقا لسياق الأفكار، الى بوليس صوفي يمنع اي هرطقة اجتماعية نقدية، أو اي شعور قومى، مؤكدا بهذا تحوله الى اداة للحفاظ على العلاقات اللامتكافئة بين غرب متقدم؛ وشرق متخلف عليه أن يبقى دائما في حضن ثقافته البدائية الجميلة!
إذا كان د.إبراهيم غلوم يفصل بين الفكرة والفن، وبين الأيديولوجيا والتجريب المسرحي، فإنه يواصل محاربة «الفكرة» داخل العمل المسرحي ذاته، مَلغِياً أشكال تَجِلْيَهَا ووجودها وتناميها في العرض المسرحي.. أو قل بأن فكرته اللاعقلانية تواصل طرد تجليات العقل في العرض.
فأي فكرة فنية لا تظهر إلا عبر الشخصية، والمعالجات، والأحداث، واللغة، ولا يوجد فن درامي ــ قصصي دون نمذجة وتجسيد.
ولكنه يصر على إلغاء هذه النمذجة عصب الفن الدرامي (والأنماط التي اعنيها هي الأنماط بجوهرها الشامل والذي نراه في طريقة بناء الشخصيات والأفكار والأساليب والمعالجات والحلول التي يقتضيها الأخذ بمنطق الأشياء) ص 6.
وهو يحولها من نمذجة إلى أنماط، بقصد استلال تنوعها وثرائها، وتصويرها في قالب آلى نمطي؛ ليسهل عليه دحرها.
وهو يحول هذه الأنماط ــ النماذج، الى سلطة قامعة للابداع. وليس إلى وسائل لثرائه كما فعل الإبداع منذ القدم حتى العصر الحديث؛ منذ سوفوكليس الى شكسبير الى نجيب سرور وسعدالله ونوس وبريخت الخ ..
وهو يريد التوجه إلى الغاء النمذجة ذاتها، وليس الطابع الآلي في النمط؛ كما يصور الأمر. فيقول عن التجريبيين العرب أمثال سعدالله ونوس ونجيب سرور وسلطة «الأنماط»، (فنجد أنها قد انتزعتهم من مهمة البحث عن جوهر المسرح، وألقت بهم في ضجيع الموضوعات وقضايا الأيديولوجيا،) ص 6.
ان النقد هنا لا يوجه الى الايدلوجيا والموضوعات فحسب، بل الى عصب الفن، وهو تجسيد النماذج – الحالات. فلن تؤدي النمذجة الا الى الارتباط بالواقع، وحياة الأمة ومشكلات المجتمع. لكن «جوهر المسرح» ــ حسب غلوم ــ هو كيان جوهري مفارق للاشياء، سرمدي، غامض؛ غير ملوث بوحل الحياة.
هنا لا يلغي الامة وقضاياها فحسب، بل يلغى الفن المسرحي أيضاً؛ انه يحوله الى رماد وغبار.
تبدأ المسيرة اللاعقلانية من السحر والبدائية والجنون الى الصوفية إلى إلغاء الفكرة والايدلوجيا والغاء الحالات والنماذج والمعالجات. لكنه ايضاً يواصل رحلة الهدم الغريبة هذه حتى يصل الى الغاء اللغة الادبية ذاتها :
(ان سلطة الكلمة في نصوص التجريب المسرحي استجابه طبيعية لسلطة الأيديولوجيا ولارتفاع صوت الخطاب السياسي)، ص 7، ويضيف (ونرى الآن أن إثبات الهوية العربية على المسرح مسألة تتناقض مع فعل التجريب؛ لأن العقل التجريبي يفترض إلغاء حواجز الهوية) ص 8 .
فالتجربب القادم من شطحات الصوفيين الغربيين؛ في عالمهم الامبريالي
المسيطر، مدعو للتسيد المطلق على التجريب العربى. إلغاء قضاياه وانتماءاته الفكرية، إزالة شخصياته وحالاته، إعدام هويته العربية، اشحاب لغته ..
هكذا يغدو «المسرح» فكرة غيبية، خارج التضاريس القومية والاجتماعية،
واللغة الإبداعية، ويتحول الى جوهر صوفي مفارق للمشكلات والنماذج والحالات ..
ولكن حتى هذا الجوهر النهائي الغامض لا نعرف اشكال وجوده الفنية، فما هو برنامج اخراجه وممثله وكيف سيظهر وقد قطع كل شرايينه مع الواقع والأشياء؟
نافذة
التجريب في الفن ليس من المحرمات، ولم يصدر أحد فرمانا بمنعه، ولم يتجرأ مبدع أو فنان، ان يعتبر ذاته خاتمة المطاف، ونهاية الخلق والإبداع.
وكان التاريخ الفني للبشرية يتجه دوماً للابتكار والتقدم، بدءاً من رسوم الصيادين على الكهوف إلى الملاحم الشعرية عند الفرس وأهل الرافدين والاغريق، وحتى الماساة الشكسبيرية وروائع تولستوي ومحفوظ الخ..
لقد كان التقدم الإبداعي هو زهرة تطور الروح البشرية، هو اقصى ما توصل اليه الانسان ليسيطر على عالمه، وذاته، ويعيد خلقهما باتجاه كون أكثر إنسانية وعدالة.
وكانت مسارات التطور في هذا الابداع تعتمد على تطور الوعي، الروح الوثابة لتشكيل العالم، آخذين في عين الاعتبار، مستويات التطور الاجتماعي – الاقتصادي. ومن هذين الجانبين كانت تتشكل تداخلات معقدة. ففي الوقت الذي كان العرب يتجهون فيه للانهيار في العصر الوسيط، كانت نتاجاتهم الإبداعية والثقافية قد وصلت الى الذروة، وفي الوقت الذي يعانون فيه الآن من التخلف، إلا أنهم أكثر إبداعاً في الرواية والقصة والمسرح من أوربا المعاصرة، بل يلحظ بشكل عام، هذا الابداع الأدبي والفني في العالم المتخلف «الثالث» قياساً بالغرب.
وليس ذلك إلا نتيجة للتكلس الروحي في الغرب، والغلبة الهائلة للمصلحة الانانية وبرود العلاقات البشرية، وفي فرنسا يمكن ملاحظة كيف تلاشت الاسماء الكبيرة سارتر، كامي دي بفوار، لتحل حالة من الفتور والانطفاء.
إن تطور الفنون يمكن أن يلحظ بدقة، في ذلك الهاجس المضطرم النابض بضرورة التغيير وتجاوز تخلف وألم الانسان. في الشعور بالتضحية ونكران الذات في الوعي باعادة تشكيل الأشياء الصعبة المؤلمة.
لقد ارتبطت تطورات الفنون دوماً بالوعي ومستويات نضجه. ففي حين تشكلت الاسطورة، الملحمة القديمة، القصة السحرية وغيرها فوق الوعي الأسطوري الخرافي، فان فنون وآداب العصور الوسطى من القصيدة الكلاسيكية. والملحمة والقصة الشعبية فوق الوعي الديني وما يرتبط به من ممارسات واشكال دنيوية.. في حين عرفت آداب وفنون العصور الحديثة هذا التوجه المتعدد الأشكال لقراءة الواقع، وتصاعدت لغة العلم في الأدب.
ويمكن ملاحظة أن تطور الفنون ارتبط كذلك بلحظات التغيير الكبرى في حياة الأمم، فالمرحلة الاولى من تطور البشرية الفني ارتبطت بالحضارات القديمة، مصر، بابل، الإغريق، الصين.
والمرحلة الثانية بالعرب والفرس وحضارة العصر الوسيط، في حين ارتبطت الثالثة بأوربا وهي تنزع أردية الإقطاع وتلبس الحداثة.
ان تطور الابداع لا يقوم على الفراغ، بل على الحاجات الحيوية للأمم في إعادة تشكيل ذاتها، وبناء لحظة حضارية متقدمة توسع حاجات الإنسان وحقوقه. واذا نظرنا بسرعة الى الآداب والفنون العربية في القرن العشرين نجد ذلك الانتقال المدهش من لحظة التعلم الساذجة الى خلق الفنون الخاصة القومية – الانسانية، بأشكالها الحديثة الأوربية، والدخول في لحظة تميز إبداعية واسعة في الرواية والمسرح والقصة القصيرة ، في العقود الأخيرة. ونجد هذه الآداب العربية وهي تتوغل في عوالمها المحلية – القومية، معيدة النظر في أسسها.
ع. خ



