قراءة في تقاسيم ضاحي بن وليد الجديدة
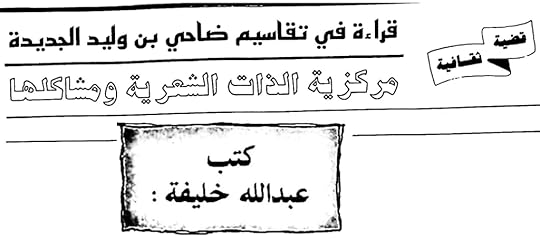
مركزية الذات الشعرية ومشاكلها
جاءت قصيدة علي الشرقاوي «تقاسيم ضاحي بن وليد الجديدة». بعد فترة من قصيدة محمود درويش «أحمد الزعتر». وهناك شيء من التأثير تركته القصيدة الاولى على قصيدة الشرقاوي اللاحقة، من حيث وجود شخصية محورية تعبر عن تجربة شعب ، أو تجربة أمة ، ومن حيث قيام الشخصية المحورية بفعل ايجابي . داخل بناء القصيدة الدرامي ، كانعكاس لفاعلية اجتماعية – شخصية متصاعدة، عبرت الشخصية – النموذج ، عن مضمونها الأساسي .
وإذا كان محمود درويش ينسحب «تماماً» من حدث القصيدة، تاركا الشخصية تنمو من خلال حوارها الذاتي المتقطع ، المتصاعد، فإن الشرقاوي لا ينسحب من القصيدة ، بل يشارك الشخصية الاخرى ، نشاطها ، بل ان شخصيته هي الشخصية المركزية في القصيدة، وصوته هو الاقوى ، وما المغني ، او شخصية ضاحي بن وليد الا لحظة من لحظات تجلي الشخصية المركزية ، التي هي ذات الشاعر.
فلم تكن شخصية ، ضاحي بن وليد ، تحتمل كل هذه المعرفة الأيدلوجية – السياسية الواسعة التي حملها إياها الشاعر، في حين كانت شخصية محمود درويش شخصية مبتدعة ، فأتاح ذلك إمكانية بنائها، وتطويرها في كافة الجهات، عبر بلورتها للتجربة الفلسطينية . لكن شخصية ضاحي كانت شخصية موسيقية وجدت فعلاً ، وعبرت عن مستوى معين من النشاط وارتبطت بمحدودية الفترة والواقع حينذاك، في حين كانت تجربة أحمد الزعتر متسعة متروكة لكافة الاحتمالات .
من هنا فإن شخصية ضاحي لم تستطع أن تحمل زخم تجربة الشاعر ، وقد بقيت ، من خلال القصيدة ذاتها ، في الحدود التي ظهرت فيها ، في الحياة ، فلم يقم الشاعر باعادة خلق لها ، او توسيعها ، ومن هنا اندفع صوته لاستكمال عملية توسيع التجربة المتنامية في القصيدة ، فغدت حياة ضاحي مجرد محطة لصوت الشاعر ، وليس شخصية كذلك . والفارق كبير هنا بين الصوت والشخصية . فالصوت هو بوح بالرؤية والفكرة ، في حين تظل التجربة الشخصية والملامح النفسية والتفاصيل الحياتية ، منفية من التجسيد الفني . فشخصية ضاحي تبقى في حدود صوته ، أي في حدود الفكرة ، التي استبدلها الشاعر بفكرته، بينما تغيب تجربة ضاحي الشخصية وممارستها اليومية الحميمة .
وهذا ، كما سنرى، يتوافق مع رؤية القصيدة وخطها الفكري . فالقصيدة لا تطرح سوى العام ، وليس الخاص ، تحاور المستوى الاجتماعي – السياسي المجرد ، لكن لا تدخل في تفاصيل الحياة اليومية والتجارب الذاتية ، فلا تمزج بين العام والخاص ، ولو فعلت ذلك لرأينا ضاحي بن وليد حقاً ، أي انسلخت شخصيته من شخصية الشاعر المسيطرة ، وغدت ذات خصوصية مستقلة . ولكن الشاعر الحقها به ، غدت صدى لنفسه ، ولقد اعطاها جوانب معينة هامة ، وهي الغناء والمعاناة ولكن لم نجدها تنمو ، في سياقها المختلف، لتتشكل في تجربتها المميزة .
في حين كان محمود درويش أكثر موضوعية بإعطاء الشخصية المحورية إمكانيات نموها الخاص ، عبر تجربتها..
(« نازلاً من نحلة الجرح، إلى تضاريس البلاد، وكانت السنة انفصال البحر»، «عن مدن الرماد»).
وتبدأ قصيدة الشرفاوي بهذين البيتين :
(منغمر في عسل التعب الطالع من حمى النحلة
منهمر في نسخ المحار الداخل احلام النخلة) .
واذا كان ثمة تشابه عبر تكرار «النحلة» في كلا المقطعين فإنهما ينموان بشكل مختلف، فالمقطع الدرويشي لا يعلن شيئاً عن الحالة الموصوفة ، انه فقط يفرش المسرح ، معيناً الظرف العام، تاركاً «البطل» التفاعلاته الخصبة مع الواقع .
لكن الشرقاوي يفتتح القصيدة بتحديد العالم الذي تدخله الشخصية والشخصية نفسها . فصوت ضاحي – الشاعر يؤكد انه منهمك في مصهر العمل القاسي في حقلي البحر والزرع ، أي في الأرض المقسمة عبر الانتاجين البحري والزراعي فالذات مغمورة بتعب الحياة الملتهب كحمى النحلة ، وهي صاعدة، عبر هذا العناء ، نحو الاحلام البعيدة المترامية في الحقول . أنها في كلا قطاعي الأرض صاعدة ، متألمة، منتعشة، متجهة إلى حلم التغيير ان صوت الشخصية يتوحد منذ البدء بالأرض ، بالإنتاج ، بالتغيير .
وهو يعيد إنتاج هذه اللازمة وتوسيعها في كل بناء القصيدة التالي . فما نمو القصيدة ألا شرح لهذا المعنى الذى كمن منذ البداية .
فتجد ان المقطع السابق يستدعي على الفور : الأرض . فهي تأتي مباشرة بعد المقطع السابق ليبدأ التداعي :
«والرملة» «هذى الألف المقصورة واقفة» في البحر كأن الفجر يحدق في تكوين الطير».
ان المقطع السابق الذى يوحي بالارض، يستدعيها فوراً على شكل خارطة ، فكأنها فجر يحدق في الطير . ويمكن عبر قراءتنا لعدة مقاطع اخرى بان نستنتج طابع القصيدة ونموها المتكرر.
وليست العلاقة في القصيدة إلا علاقة صراع بين الأنا الشعرية ، وصوت الشاعر ، والواقع الخارجي . إن هذا الصراع هو الصراع الأساسي المحوري. وما ضاحي بن وليد ، الا لحظة من لحظات تجلي هذه الأنا الشعرية، التي سرعان ما تتجاوز صوت ضاحي الخاص ، وما موسيقاه ، أو شظاياها ، الا جزء آخر من هذه الذات الشعرية ، التي تنمو وتنساب في كل الجهات وستغدو مدعوة لإحياء المشنوقين والمتلاشين ، فهي الصوت المكثف لإخراج العرب من ظلماتهم وهي الباعثة لحيواتهم الميتة … في مواجهة الفعل التدميري للغرب ، الذي سيؤخذ ، كجوهر آخر ، معاد ومرفوض ، كلية .
ان المقاطع الأولى التي تبدأ بها اللوحة تتكيء بقوة على صوت المغنى القديم، فصوت الأنا الشعرية يتوغل في ذاته ، يبحث عن لحظة الصعود الدرامية، فتمتلئ المقاطع بكلمة . «احاول»:
«احاول عتق الغبن المرهق في الشفتين» ، «احاول ان اجتاز بمهماز الوجد تخوم المابين».
(«واحاول» ، «مجروح وقتي» ، «من فض بكارة صوتي البدوي واعطاها السفلس ؟؟» ، «من لوث بالآلات الغربية موال النرجس» ، «من عقلني ؟»).
إن هذه المحاولات الدائبة للخروج تصطدم بالوقت بالواقع . وتغدو القصيدة تجربة ابداعية تحاول أن تتغلغل في هذا الواقع . وسيكون هذا الواقع واحداً ، حتى لو امتد الى الماضي ، عند بداية القرن ، في زمن ضاحي المغنى ، أو جاء الى الوقت الراهن ، زمن العقد الثامن، حتى لو امتد الى المغرب او عاد الى المشرق ، تجلى في الاغنية القديمة ، أو القصيدة المعاصرة ، انه واقع واحد ثابت ، عام ..
وهذا الواقع هو واقع الغاء الصوت البدوي ، او العربي ، او الشرقي أو «النحن». لهذا هو ليس واقعاً عربياً ، انه واقع غربي ، اجنبي . لأنه ليس بدوياً ، ليس عربياً صميماً . لا يستخدم العود، الآلة العربية الموسيقية ، الاصلية ، بل يستخدم الآلات الغربية . فصار العرب ، حسب هذه الرؤية ، اسرى واقع لا يصنعونه .
كيف إذن سيتشكل الصراع بين الأنا الشعرية والواقع العربي ؟ كيف ستقوم باستعادته ، هي الحرة وهو المستعبد ، هي البدوية وهو الغربي ، هي الانتماء وهو الاستسلام ، هي الاصالة وهو الزيف ؟!
انها تتراجع الى ذاتها. الى تعدد تجليات هذه الذات في حوارها الداخلي ، فيعود صوت الشاعر – المغنى ليحفر في نفسه ، سوف يسترجع اشكال مقاومتها ، حيث كانت الكلمة وسيلة لصعود المقاومة الداخلية ، والانغام البدوية صورة من صور الرعد الخالقة .
أن التغييرات الحاسمة لا تحدث الا في كون الأنا الداخلي ، بينما نرى الواقع الخارجي ، الواقع العربي ، كهفاً واسعاً بلا تغيير:
(«كهف في المشرق» ، «كهف في المغرب» ، «كهف» «ما اضيعه الزمن العربي على النغم الانثى» ، «ما اكثر ادوات النفي !!).
إن هذا الواقع العربي . الممتد من بداية القرن ، الى الآن ، وهذا الجسد العربي الكبير المتواصل المتقطع بين المحيط والخليج ، هو مجرد كهف ، انه الظلمة ، واللا حركة ، بينما يكمن النور في الأنا الشعرية ، فهي الحركة والفعل، وهي التي سنجدها تشتعل بالتغيرات والفاعلية والعطاء .
انها تبحث ، وتدور ، قد تتخثر احياناً ، قد تتمزق ، قد تموت مع الموت ، لكنها تعود للحياة، فهي الحياة ! أن المغنى يعود للحضور، والشاعر يتجسد باستمرار ، ليس في تضاريسهما اليومية ، ليس في فعلهما الحقيقي ، مثل احمد الزعتر وهو يتقلب في العربات المشتعلة بالغربة وفي الزنازن الشقيقة ويولد في معارك المخيمات، بل هما ، أو قل هي الانا الشعرية بؤرة القصيدة وسيدتها المطلقة، في نضالها الثقافي المجرد ، حين تستخدم الريشة لصياغة الكلام الممنوع ، وحين تنشىء طريقاً من بين الظلمات ، يكسر حد الجوع » .
انها الريشة ، أو الكلمة ، وهي تفعل وتخلق. «اراجيحاً للعيد» ، و«زغاريد الاعراس » و«تحول .. قداس الفرحة رمزاً» ، و«تكشف» ، «عمق اللغز» ،.. (ص 191 من كتاب قراءة نقدية في قصيدة حياة للدكتور علوي الهاشمي).
إن الأنا الشعرية بتجلياتها، عبر ضاحي ، عبر الريشة ، أو عبر القصيدة ، تقوم ضمناً باعادة النور والحياة الى الجسد العربي الميت ، تبعثه ، تحييه ، لا بالتوغل بين جموعه وتضاريسه ، تستكشفها، وتقودها في مسارات الأرض، كما فعل أحمد الزعتر ، الذي ظهر كأحمد الشعبي واليومي ، متشكلاً بين الناس ، ومفجراً لطاقاتهم معاً .. لا ، ليس مثل ذلك ، بل عبر نفثها هي للحياة في الجسد العربي الميت – الكهف . انها مصدر الضوء والطاقة والخلق !
إن الوعي الثقافي ، كما تتصور الأنا ، هو أساس خلق العرب وإعادة تكوينهم ، أو بعثهم ، وهو وعي تنفثه الذات، من مصدرها العلوي، ومن هنا فهي ليست بحاجة للدخول الى تفاصيل حيواتهم وعوالمهم المختلفة ، فيكفي انها تراه هكذا ، كهفاً واسعاً ، حتى يكون فعلاً كما تري ..
إذن لا يبقى لهذا الوعي الثقافي النخبوي ، الا ان يلغي الثقافة الغربية ، لكي يبرأ الجسم العربي من العلل والظلام ..
«مبحوح قلبي»، «فحيح الآلات الغربية»، «تحت السقف الديناري المغزول من الآهات على الوتر الصامت علبني»، «من شيأ صوتك يا عود النار ؟) .
فالمواجهة ستجري بين العود والآلات الغربية، بين الثقافة العربية والثقافة الغربية ، بين الشرق والغرب ، بين النحن والآخر، بين عالمين متناقضين لا يلتقيان ورغم أن الثقافة الموسيقية العربية تفاعلت مع الثقافة الموسيقية الغربية واغتنت بها كما اغتنت كافة أشكال الوعي العربي ، إلا أن الأنا الشعرية ، لا ترى ذلك ، وترى التقابل المطلق والتنافر الأبدي بين الشرق والغرب ، بين العود والآلات الغربية !
وتستمر آلية الصراع هذه في العديد من المقاطع التالية ، تعيد تكرار الرؤية ، كهذا المقطع :
(«العود الهجس»، «مثل المخطوطة»، «من يكتشف النغم الانثى»، هذا المغمور كعرق النور بخارطة الحزن العربي»)، ص 193.
فالعود ، كالمخطوطة ، تجليان للثقافة العربية، وهما أساس خلق الفعل للجسد ، هما مولدا النور في خارطة الظلمة العربية . هما اللذان يشكلان الخصب للجسد ، هما الفعل الذكوري (مع مجيء الريشة) لصناعة المولود العربي .
ويوضح ذلك ايضاً بعدها (هل غير العازف في الظلمات هناك نبي ؟) فالظلمات المتكاثفة في الكهف العربي ، لا تزيحها إلا الثقافة العربية النخبوية: صناعة المثقفين المتميزين ، صناعة الأنبياء . وهنا ينفتح باب الثقافة الصوفية المثالية ، بعد أن فقدت القصيدة طريقها في العثور على الحقيقي بين المبدع والناس ، بين الطليعة والشعب . أو قل بان تصور الثقافة باعتبارها صانعة التاريخ بشكل مطلق ، وبان المبدع هو خالق الجسد العربي الجديد ، قد فتح الأبواب ليتحول هذا المبدع الى وعى مقطوع الجذور بالواقع ، ليأتيه الوعي من الخارج ، من السماء ..



