عبـــــــدالله خلــــــــيفة's Blog: https://isaalbuflasablog.wordpress.com , page 24
December 17, 2023
ابن باجة* : كتب ــ عبدالله خليفة
1 ــ معنى التوحد
في كتابه (تدبير المتوحد ) يتوجهُ ابن باجة إلى تعبيرٍ جديدٍ في الفلسفة العربية الإسلامية هو (التدبير) ، ويُقصد به ( ترتيب الأفعال نحو غايةٍ مقصودةٍ ) ، (1 ) وهذا التدبيرُ يتصفُ بالكثرةِ ويُؤخذُ من حيث هو ترتيب ، ويتصفُ بارتباطهِ بالأعمال الكبرى في الحياة ولهذا ( يُقال في ترتيب الأمور الحربية ) ، ( وأشرف الأمور التي يُقال عليها التدبير هو تدبير المدن وتدبير المنزل ) ، (2 ) .
ويتداخلُ تصنيفُ ابن باجة هنا في التدبير مع فلسفتي أفلاطون والفارابي اللذين يذكرهما في الفصل الأول مراراً ، والفلسفتان هما المتعلقتان بالجمهورية أو بالمدن الفاضلة ، ولهذا تأتي ألفاظٌ في هذا الفصل مثل (الصناعة المدنية) و(المدينة الفاضلة) ص 8 ، فتتداخلُ كلمةُ (المنزل) مع المدينة على نحوٍ غامضٍ في تعبيراته التي تمتاز بالتداخل وعدم الوضوح :
(فإن وجوده الأفضل أن يكون مشتركاً ، وكيف صفة اشتراكه ؟ وأما المنزل في غير المدينة الفاضلة ، وهو المدن الأربع التي عدت ، فإن المنزلَ فيها وجوده ناقص وأن فيه أمراً خارجاً عن الطبع ، وأن ذلك المنزل فقط هو الكامل الذي لا يمكن فيه زيادة فلا تعدو ناقصاً ، كالأصبع السادسة ) ، (3) .
من الواضح هنا بأن المنزل هو ( جزءٌ من المدينة ) ص 8 ، وإن ابن باجة يشيرُ إلى رؤية أفلاطون للحياة المنزلية المشتركة ، وللمشاعة الأسرية ، حيث يتمُ إلغاء الملكية الخاصة ، وتتشاركُ المجموعاتُ الأسريةُ في الملكية العامة ، وبهذا فإن تدبير المنزل هو جزءٌ من تدبير المدينة ، وإن المنزل الكامل هو ذو الملكية الجماعية ، ومن هنا نفهم عبارته في هذا السياق الغامض والتي يقولُ فيها : ( إن الزيادة فيه نقصان . وأن سائر المنازل ناقصة بالإضافة إليه ومريضة ، لأن الأحوال التي تباين بها المنزل الفاضل تؤدي إلى هلاك المنزل وبواره ، ولذلك تشبه المرض ) ، (4) .
إن المنزل الاجتماعي الراهن والذي تسودُ فيه الملكية الخاصة واللامساواة هو منزلٌ ليس فاضلاً كما نفهم من نصه ، (فإنه إن خلا منزل من ذلك لم يكن أن يبقى ولا كان منزلاً إلا باشتراك الأسم . فلنترك القولَ فيه ولنعرجَ عنه لمن تفرغ للقول في الأمور الموجودة وقتاً ما .) ، (5) .
ورغم إنه هنا يقولُ بإنه سيدعُ أمر المنزلِ إلا أنه يواصل التعبير عنه بهذا الشكل اللغوي المضطرب ، ويخلصُ إلى القول : (وهو بينٌ أن القول فيه جزءٌ من القول في تدبير الإنسان نفسه) ، (6) .
إن ابن باجة وهو يقطعُ علاقةَ أفكارهِ بأصولها الأفلاطونية لا يوضحُ بأن المقصودَ بها هو نظرة أفلاطون إلى الحياة الأسرية المشاعية ، وأن الأسرة المشاعية هي أساس المدينة الفاضلة التي يتوخى الحديث عنها ، فهي الأساس الأسري والاجتماعي لتكوين مدينة فاضلة انتفت منها الملكيات الخاصة ، وبهذا فهو يعبرُ بالألغاز عن أفكار عبرعنها الفارابي في مدنه الفاضلة سابقة الذكر (7) ، ثم يضطربُ مرة أخرى فيقول : (فمن ها هنا تبين أن القول في تدبير المنزل على ما هو مشهور ، ليس له جدوى ولا هو علم ، بل إن كان فوقتاً ما ، كما يعرض ذلك فيما كتبه البلاغيون في كتب الآداب التي يسمونها نفسانية مثل كتاب كليلة ودمنة ومثل كتاب حكماء العرب ، المشتملة على الوصايا المشورية ) ، .
إنه لا يريدُ أن يعبرَ عن فكرتهِ بوضوح وكون الحياة الأسرية المثالية مرتبطة بإنتاج ملكية مختلفة عن الملكية الخاصة وعن تربية الأطفال السائدة ، فينقضُ نصَـه السابق بكون تدبير المنزل جزءٌ من تدبير النظام الاجتماعي العام ، المراد تشكيله بديلاً عن النظام الفاسد الراهن ، فلا يعرض شيئاً آخر ويتوه في زقاق فكري جانبي ، فلا نعرفُ ما المقصود بإدراج كليلة ودمنة في معرض الحديث عن تدبير المنزل والمدينة ؟
فكليلة ودمنة تتعلقُ بحكايات رمزية ذات هدف إصلاحي يستهدفُ تغيير الدولة والمجتمع من منطلق خاص ، (9) ، لكننا لا نرى تحليلاً يربطُ ما بين وضع الأسرة والمدينة في جمهورية أفلاطون وفي كليلة ودمنة ، حيث يتوجه أفلاطون إلى تشكيل مجتمع مثالي خيالي ، في حين يقومُ ابن المقفع بنقد السلطة المطلقة للأسد – الملك ، وإذا كان كلاهما يتجهان للإصلاح فعلاً فمن منطلقات مختلفة كثيراً ، لكن ابن باجة لا يقومُ في كتابهِ بهذا التحليل ، وهنا نجدُ الثغرات المتعددة التي تــُتركُ بين الأفكار والرموز المحللة والكتب المُستشهد بها .
وسنرى لاحقاً لدى ابن رشد كيف تتم عملية تكميل مشروع ابن باجة هذا ، خاصة من زاوية تحليل جمهورية أفلاطون ، ومقاربتها للمجتمع الإسلامي (10) .
وبعد هذا العرض المأخوذ بتصرفٍ مرتبك من أفلاطون والفارابي ، فابن باجة يتوجه بسرعةٍ شديدة لوصف المدينة الفاضلة بأنها (تختصُ بعدم صناعة الطب وصناعة القضاء) (11) ، دون أن يمهد لعرض طبيعة هذه المدينة الفاضلة إنتاجاً وعلاقات اجتماعية وسياسية ، فيندفع لوصف جوانبها الشديدة المثالية وغير الواقعية وخاصة ما يتعلق بإلغاء علم الطب !
ويعلل ذلك بقوله :
( وذلك أن المحبة بينهم أجمع فلا تشاكس بينهم أصلاً ، فلذلك إذا عري جزءٌ منها من المحبة ووقع التشاكس احتيج إلى وضع العدل واحتيج ضرورة إلى من يقول به ، وهو القاضي ، وأيضاً فإن المدينة الفاضلة أفعالها كلها صواب . . ولذلك لا يتغذى أهلها بالأغذية الضارة . .) ، ( 12) .
إنه وبعد أن عزل الأسس التي أقيمت عليها هذه المدينة الفاضلة يقومُ بعرضِ مزاياها الخيالية ، حيث كمالها غير المبرر يؤدي إلى ظاهرات مثل غياب القضاة والأطباء ، لأنه لا توجد صراعات فيها ، ولا توجد أمراضٌ ويتصور بأن الأمراض كلها ناتجة عن سوء الغذاء ، ومتى ما كان الغذاء صحياً فلا طريق إلى تسلل الأمراض إلى هذه المدينة الكاملة .
وأما المدن الأربع الناقصة فإنه يجري فيها مثل ذلك ، وهنا لا ندري عبر هذا الكتاب ما هي المدن الأربع ، فالمؤلف لم يعرض كما قلنا بتسلسلٍ واضح أفكار المعلمين السابقين الذين يستقي منهما هذه الأفكار .
وهكذا يقارن بشكلٍ متكررٍ ودائم ومتقطع ومتداخل بين هذه المدن الأربع والمدينة الخامسة – النموذج المطلوب ، فالعادات السيئة والشريرة كالكذب والفساد كلها في المدن الأربع ، ويمثل (النوابت) الشكل الاجتماعي الغامض لكل هذه الشرور :
(فبينٌ أن من خواص المدينة الكاملة أن لا يكون فيها نوابت ، إذا قيل هذا الاسم بخصوص ، لأنه لا آراء كاذبة فيها ، ولا بعموم ، فإنه متى كان ، فقد مرضت وانتقضت أمورها وصارت غير كاملة) ، (13) .
ونظراً لسيادة المدن الناقصة فإن التغيير كما يراه ابن باجة يكون عبر تشكل نموذج أفراد هو الذي أطلق عليه اسم كتابه (تدبير المتوحد) فهؤلاء الأفراد يقومون بفعل التدبير المتوحد الذي يشكل تلك (النظافة) الأخلاقية والاجتماعية الطوباوية التي يدعو لها ابن باجة ، ولكن من الممكن أن يكون المتوحد أكثر من فرد ، وأن يكون ثمة متوحدون ، (ما لم يجتمع على رأيهم أمة أو مدينة) ص 13 ، فمن الممكن في رأيه أن ينمو هذا التوحد ويشكل فعلاً جماعياً ، ولكن كيف وهم أفراد متوحدون ؟
(لأنهم ، وإن كانوا في أوطانهم وبين اترابهم وجيرانهم ، غرباء في آرائهم ، قد سافروا بأفكارهم إلى مراتب أخر هي لهم كالأوطان ، إلى سائر ما يقولونه .) ، (14) .
2 ــ النفس والأخلاق
وبخلاف الفلاسفة المشارقة المسلمين الذين يبحثون صورة الذات الإلهية كما يتخيلونها ويتحدثون عن الفيض الغيبي ، فإن ابن باجة كما رأينا في الفصل الأول يتوجه لبحث معنى عنوان كتابه ، متوجهاً إلى الإنسان المفرد ، كي يدعوه إلى نظرة معينة ، هي أن يكون مختلفاً في مدن الشر والفساد ، وفي الفصل الثاني يكملُ هذا البحث متجهاً إلى بحث النفس والأخلاق.
إنه لا يأتي بجديد أثناء عرضِ أصناف النفس ومستوياتها حيث النفس المغذية والمولــِّدة والنامية ، وكذلك لا يأتي بجديد في العلاقات المتداخلة بين الكائنات ، وكون الإنسان هو تتويج الكائنات الحية كما تطرح الفلسفة الدينية عامة ، كذلك فإن رؤيته لكون الزهد والسمو الأخلاقي هو جوهرُ الكائن الإنساني ، هو أيضاً متابعة للفارابي وغيره ، لكنه يقومُ بالتغلغل في جوانب جزئية لهذا السمو ، عبر رؤية التداخل ما بين (البهيمي ) والإنساني ، ويصيرُ المتوحدُ هنا هو القادر على الصعود المستمر من الأفعال البهيمية نحو الكمال الأخلاقي ، لكن لا نجد ذلك الانسحاب من المجتمع والأنزواء ، كما أن الغيبيات الكثيفة حول النفس لا نجدها لدى ابن باجة بل أن المتوحد هو إنسانٌ داخل الحياة الاجتماعية ، أما النفس الكونية والعجائبية لدى الفلاسفة المشارقة فإنها تغدو هنا مجرد نفسٍ إنسانية فردية بسيطة تسعى للارتفاع بأفعالها عن الخسة وعن الأعمال غير الأخلاقية ، جاعلةً هذه الأفعال الخيرة هي بؤرة وجودها .
هنا نلمحُ الفردَ المنتمي للفئات الوسطى وهو يستشعرُ فرديتــَهُ ويرفضُ المدنَ الأربع الرديئة التي نفاها الفارابي ، لكن ابن باجة لا يتحدثُ عنها بوضوح ، ويظلُ ملتفاً بجملٍ غامضة ، داعياً الأفراد المتشابهين (المتوحدين) إلى التماثل الأخلاقي المثالي .
ولا شك أن هذه الدعوة هي بحدِ ذاتها لغةُ تعارضٍ مع الدولةِ منتجةِ الفساد العام ، ولهذا سنلاحظ كيفيةَ تشكل اللغة الفكرية لابن باجة كلغةٍ منولوجيةٍ تلخيصيةٍ تحليلية متقطعة متنامية ، كمحاولةٍ لبلورةِ معنىً نقدي مضطرب .
3 ـــ العقل والصورة
إن ابن باجة يواصلُ تلخيصَ الفلسفة الأرسطية والمشرقية فيتحدثُ في فصل (القول في الصور الروحانية ) عن الروح والنفس اللتين يراهما كتكوينٍ واحدٍ ، ويلخصُ رؤى من سبقوه بقوله :
(والروحاني منسوبٌ إلى الروح . . ويدلون به على الجواهر الساكنة المحركة لسواها ، وهذه ضرورة ليست أجساماً ، بل هي صورٌ لأجسام . .) ، (15) وفي هذا نجدُ استمرارَ رؤية الروح كجوهر ، وليس كعمليات ، ولكن ابن باجة ينعطفُ بالتعبير نحو جانبٍ جديدٍ فهذه الجواهر ليست أجساماً بل صوراً ، أي هي عملياتٌ عقلية داخلية في وعي الإنسان ، وبهذا فإن ابن باجة يفارقُ غيبيات الفلاسفة المشرقيين ويتجاوزُ تشكلَ الروح كما تتمظهرُ في ما وراء الطبيعة وبالشكل اللاعقلاني السائد ، ويحددُ أنواعَ العقول المؤسسة أرسطياً ومشرقياً كالتالي :
(والصورُ الروحانيةُ أصنافٌ . أولها صورُ الأجسام المستديرة ، والصنف الثاني العقل الفعال والعقل المستفاد ، والثالث المعقولات الهيولانية ، والرابع المعاني الموجودة في قوى النقس ، وهي الحس المشترك وفي قوة التخيل وفي قوة التذكر) .
ويكررُ ابنُ باجة ما هو معروف ، ولكنه يعرضُ جانباً منها بصورةٍ جديدة أيضاً ، فالعقل المستفاد هو متممٌ للعقول وللصور المادية في عقل الإنسان ، فهو يتشكلُ عبر تلاقحٍ جدلي بين الأشياء والعمليات وبين الفكرة ، فهو غيرُ منفصلٍ عن مرئيات الواقع ولا عن النمو الفكري الداخلي في الإنسان .
في حين يغدو العقل الفعال هو (الفاعل لها) ص 21 ، أما الصنف الرابع الموجود في قوى النفس والحس المشترك والتخيل (فهو وسط بين المعقولات الهيولانية والصور الروحانية) ، (16) .
يتضحُ هنا كيف أن ابن باجة يعقلن الصورَ والأفكار الروحية الميتافيزيقية ، فيقطعُ الماورائيات الغيبيةَ الكثيفة ، فهو يقولُ عن صورِ الأجسام المستديرة ، وهي الكواكب والنجوم التي تلعبُ دوراً حيوياً في الفلسفة المشرقية : (وأما الصنفُ الأولُ فنحن نعرضُ عنه في هذا القول ، إذ لا مدخل له فيما نريدُ أن نقوله ) ، ص 22 .
إن إزاحة هذا الدور يتم هنا بغموض كذلك ، فهل هو تأجيلٌ للبحث أم إلغاءٌ من التأثير؟
لا نعرف ذلك ، وهو يواصلُ هدمَ غيبيات الفلسفة المشرقية حين يأتي لدور العقل الفعال الذي يأخذُ لديه :
(وإنما نستعملُ في هذا القول الروحاني المطلق ، وهو العقل الفعال وما يُنسبُ إليهِ ، وهو المعقولات . وأسمي في هذا القول هذه المعقولات بالروحانية العامة ، وأسمي ما دونها أي الصور الموجودة في الحس المشترك ، الروحانية الخاصة ، وسيتبينُ بعد ذلك هذا لمَ أخصُ هذا بالخاصة وتلك بالعامة) ، (17).
وإذ لا يهتم ابن باجة بالتشكيل الغيبي للعقل الفعال فهو يهتمُ بتكونه الموضوعي المادي ، فنرى تركاً لمتابعة العقل المفارق وتركيزاً على العقل الأرضي .
فالصورُ الروحانيةُ العامة التي جاءت من العقل الفعال (لها نسبة واحدة خاصة ، وهي نسبتها إلى الإنسان الذي يعقلها . أما الصورُ الروحانية الخاصة فلها نسبتان . إحداهما خاصة ، وهي نسبتها إلى المحسوس ، والأخرى عامة ، وهي نسبتها إلى الحاس المُدرك لها ، مثال ذلك صورة جبل أُحد عند من أحسه . .) ، (18) .
وبعد أن قطع ابنُ باجة العلاقات الغامضة الغيبية بين العقل وما وراء الطبيعة ، فإنه يبحثُ في الفصل الثاني مدى يقينية تلك الصور المعرفية ، ومدى مطابقتها للحقيقة التي تتجسدُ لديه في الواقع .
ولكي تكونُ الصورةُ صادقة فلا بد أن تتجاوزَ ضعفَ الحواس :
(فإن الحسَ قد يكذب . مثالُ ذلك ، حس المحرورين بالأشخاص التي يخاطبونها حسٌ كاذبٌ . وكذا طعم أصناف من المرضى كاذب ، والإنسان بالصور الورحانية المختلطة صادق وكاذب وأفضل الصور الروحانية ما مر بالحس المشترك) ، (19) .
وتمثلُ ذاكرة الحس المشترك الجوانبَ الانعكاسية المباشرة من الطبيعة والمجتمع والأشياء ، ثم تغدو الصورة أقل جسمية في الذاكرة ، ثم تنتفي علاقتها المادية المباشرة في (القوة الناطقة) ، حسب التعبير بالرموز عن الصور .
إن الصورَ تتصاعدُ من الخاص إلى العام : (فإنه كلما وُجدت النسبة الخاصة ففيها جسمية) ، فإذا ارتفعت الجسمية وصارت روحانية محضةً لم يبق إلا نسبتها العامة) .
وإذا كانت الصورُ تتشكلُ عبر الحس السليم فإن ابن باجة يقولُ أيضاً أنها تتشكل عبر الحدس ، ولكن (هذه فلا تكون باختيار إنسان ، ولا له في وجودها أثر يدخلُ في هذا القول . وأيضاً فإنها موجودة في الفرد من الناس في النادر من الزمان ، فلا يتقوم من هذا الصنف من الموجودات صناعة أصلاً ولا نحوه تدبير إنساني ، فلذلك لا مدخل له في هذا القول) ، (20).
فإذا كانت المعرفة الصادقة هي نتاجُ الوعي المباشر والمتصاعد من الحس المشترك إلى اللغة ، فإن الحدس لدى الفيلسوف هو عملية نادرة فردية تتم بشكلٍ غير إرادي ، ولكن هذه الحدوس لدى المحدثين وأصحاب الرؤى: (فهي زائدة على الأمر الطبيعي لكنها مواهب إلهية . وهذه لا يحدث عنها صناعة ، لأنها في الأقل من الناس . بل الأمر الطبيعي هو التوسط ، وهو وجود الظن مختلطاً ، وأفضل هذه الوجودات أن يكون أكثر ظنونه صادقة وأن لا تختلط ، إلا فيما شأنه ذلك ، (21) . فالحدوسُ لا يمكن الاعتماد عليها في بناء نظرة عامة للمعرفة .
تتجهُ نظريةُ المعرفة عند ابن باجة إلى الاعتماد على الحس والمحسوس وتصعيد دورها ، فيقولُ بأن (اليقينية من محمولات الصور الخاصة ، فهي المحمولات التي توجد أشخاصها في الصور الجسمانية ، ولذلك ترك بالحس) ، (22) وهذه العملية المعرفية هي التي تنطلقُ من الحواس التي تتعاونُ مع بعضٍ لتكوين الصور ، ولكنه لا يكتفي بها فقط بل أيضاً يدخل الفكر (وربما احتيج إلى القوة الفكرية كذلك ) ، ص 28 . وكذلك ينشأ القياس من الصور ومن تداخل الوعي ، ص 28.
إذن عبر الحواس والفكر والقياس تتشكلُ المنظومة المعرفية :
(فلذلك إذا اجتمعت القوى الثلاث حضرت الصورة الروحانية ، كأنها محسوسة ، لأنها عند اجتماعها يكونُ الصدقُ ضرورةً ويشاهد العجب من فعلها) ، (23).
إن انفصال الفكر عن الحس قد تتمظهر عنه : (صورٌ غريبة ومحسوساتٌ بالقوة هائلة المنظر وأنفس أحسن كثيراً مما في الوجود) ص 23 ، وعلى هذا النحو من التضخم الصوري – النفسي أدرك الغزالي الأشياءَ ، كما يواصل التحليل ، ثم يصلُ إلى هذه العبارة الخطيرة في الفلسفة العربية الإسلامية :
(ولذلك زعم الصوفية أن إدراك السعادة القصوى قد يكون بلا تعلم ، بل بالتفرغ وبأن لا يخلو طرفة عين عن ذكر المطلق ، ولأنه متى فعل ذلك أجتمعت القوى الثلاث وأمكن ذلك ، وذلك كله ظن ، وفعل ما ظنوا أمر خارج عن الطبع . وهذه الغاية التي ظنوها إذن لو كانت صادقة وغاية للمتوحد ، فإدراكها بالعرض لا بالذات ، ولو أُدركت لما كان منها مدينة ولبقي أشرف أجزاء الإنسان فضلاً لا عمل له ، وكان وجوده باطلاً ، وكان يبطل جميع التعاليم والعلوم الثلاثة التي هي الحكمة النظرية ولا هذه بل والصنائع الظنونية كالنحو وما جانسه ) ، (24) .
عبر (اليقين في محمولات الصور الروحانية بالذات) ، وعبر (الأخبار وتواترها ) (واجتماع القوة الفكرية مع القوة الذاكرة) وأن هذه كلها إذا لم (يتحد مع الحس) : (لم تحضر صورة الشيء كما هو في الوجود) ، ص 30 .
ولكي يغدو متوحد ابن باجة غير متوحد الصوفية عبر هذه النظرية المعرفية التي تكشف العالم الموضوعي ، لا بد له من أخلاقيات مختلفة :
(ونحن إنما نقصدُ فيما نحن بسبيله تدبير المتوحد ، ومن الصور الروحانية الكاذبة يكون الرياء والمكر وقوى أخر شبيهة به ) ، (25) .
تغدو وسائل الكذب والتمويه المتسعملة من قبل القوى المسيطرة فضائل عند المخدوعين بها ، ولهذا فإنهم كما يقول ابن باجة يفضلون معاوية بن أبي سفيان على علي بن أبي طالب ، وفي هذه الانعطافة السياسية الفكرية لدى الفيلسوف تترابط قضايا الوعي الأخلاقي بالبنى الاجتماعية العربية ، حيث كانت كل الرذائل وطرق التفكير المتداخلة معها هي أشكال الوعي والسلوك لدى الأشراف الحاكمين ، في حين تكون لدى المتوحد نقائضها .
فكلما ازدادت الفضائل والمعرفة كلما هيمنت على المتوحد روحانيته لا جسمانيته ، فيغدو التطور الروحي الأخلاقي هو أساس التكوين البشري ، رغم أن ذلك لا ينقطع عن الاهتمام كذلك بالجسد .
والطابع الاجتماعي لدى ابن باجة لعملية تشكل الفضائل والمعرفة واضحة فهؤلاء الجسمانيون المتوقفون عند الحس يتجسدون في هذه الأوصاف :
(التأنق في أنصاف المطاعم والروائح) ، (السُكر ، ولعب الشطرنج ، والصيد للالتذاذ) وبطبيعة الحال فمن يستطيع ذلك هم (الصنف القليل من الناس) .
ولكي يوضح تماماً وجودهم الاجتماعي يقول :
(وهذا الصنف إنما يوجد أكثر في أعقاب ذوي الأحساب . وعلى أمثال هؤلاء ينقطع ثبوت شرف الإنسان . ولذلك إنما ينتقلُ الهولُ عن أجناس الأمم على أيدي هؤلاء) ، (26) .
هذا هو التقييم الفكري – الثقافي لمسيرة هيمنة الأشراف على المعرفة والأخلاق ، فهذه السيطرة تقود إلى فقدان الشرف ، وبطبيعة الحال فإن التدهور (الهول) يتشكلُ عبر هذه السيادة التي تفرغ العرب والمسلمين من ذلك الاهتمام بالمعرفة والسمو بالروح .
ويواصل ابن باجة كشف الطابع الاجتماعي عبر التحديد السياسي لأصحاب الحسب ، فيقول :
(وذلك موجود كثيراً في هذا الزمن الذي كتبنا فيه هذا القول ، وكان في هذه البلاد في سيرة ملوك الطوائف أكثر . وهؤلاء يعرفون بالمتجملين ، وتلقب هذه السيرة بالتجمل ، فلذلك يقال أن التجمل يذهب بالمال ، ويتوسلون به في حوائجهم عن أكابرهم ويهرجون ويمرجون بها) ، (27 ) .
هكذا عبر الزهد والتطلع إلى الجوانب الروحية الرفيعة وترك مباذل المتع ودون إزالة تطلعات الجسد الإنسانية ، يتكشف المثقف التحديثي الطالع من صفوف الفئات الوسطى ، وهو يتوجه للمعرفة ويشكل منهجاً يقوم على (التفكير الاستدلالي والاحتجاج المنطقي ) كما يصف هنري كوربان الفلاسفة اليونان ، وفي مواقع أخرى تلامذتهم العرب المسلمين ، (28)
وهو الآن يتحدث عن الفضائل الأخلاقية والاجتماعية التي سيدها أهلُ الأحساب ، وهو يقرأها بشكلٍ عامٍ تجريدي مثالي ، فهو يواصلُ القولَ عن ذوي الأحساب وأخلاقهم :
(وجميع الآراء المكتوبة والراقية مطبقة على ذم هؤلاء الناس) ، ونلاحظ كلمة (الراقية) تعطينا فصلاً بين نمطين من القوى الاجتماعية ، حيث يغدو أهل الأحساب معبرين عن تدهور اجتماعي ، لا عن رفعة ، وتتجسد عملية التدهور في الوضع المادي المعيشي أولاً عبر الملابس وأحوال المساكن ووضع المأكل والمشرب ، وعبارات ابن باجة هنا عامة غائمة :
(وقليل ما توجد له هاتان مفردتين ، لكنه أكثر من الأول . وإنما عـُدت هذه نبلاً لمواقع الصور الروحانية منها . وعلى أمثال هؤلاء تنقرضُ الدولُ في الأكثر) ، (29) .
وهو يقصدُ هنا بأن الكثير من الناس لديه هذه الصور المعيشية وهي تراها (نبلاً) حيث هي صورة (الرقي) المتعارف عليها ، ونلاحظ هنا الخميرة الفكرية التي ستغدو عند ابن خلدون بؤرة مركزية في تاريخه الاجتماعي .
ومن هذه الصور ما تكون الطبقة الحاكمة به المظاهر ويـُقصد منه الانفعال ، أي التأثير الاجتماعي ، (كلباس السلاح في غير الحرب ومالعبوس وسائر الهيآت النفسانية ، وفي هذا يدخل ما يصنعه الملوك عندما يدخلُ إليهم العامةُ والغرباءُ عنهم كالرسل . .) ، (ومنها ما يقصد الالتذاذ كالشتم والتودد ، والبر ، والهزل داخل في هذا الصنف ، وكثير من الملابس والمساكن التي تيعجب منه) ، (ومنها ما يقصد به الكمال فقط ، وأن عرض فيه بعض هذه فالبعض ، وهي الفضائل الفكرية وهي العلوم والعقل) .
وهو يرى بأن هذه (يـُقصد منها أن تولد في النفس خشوعاً ، فتعقبه الكرامة وسائر الخيرات) ، (30) .
إن كل هذه الجوانب (الأخلاقية) يقصد منها الخضوع ، وتظهر الثقافة الرفيعة في البلاطات هذه كظاهرات جانبية ليست من صلب وظيفتها .
كذلك فإن (العمل الفاضل) جزءٌ من هذه الصورة الأخلاقية المكرسة في عمل النخب والحكومات هذه ، ومعيارها أن تكون للحق والفضيلة ، وهو هنا يستشهد بحديث نبوي حول الهجرة وكذلك حديث (إن الأعمال بالنيات ولكل أمرئٍ ما نوى ) . إن ابن باجة يحول مسار البحث في الأخلاق إلى مسار ديني مثالي ، بدلاً من أن يواصل الحفر في الإرث العربي الإسلامي بالشكل الاجتماعي السابق .
ثم يواصل تعداد الفضائل المشكلة لتطور الروح كالتعليم وصنع المكرمات لذاتها ، ويجعلُ الثقافة الرفيعة تتويجاً لهذه الفضائل : (فقد تلخص أمر المدينة جملةً في العلم المدني ، والروية والبحث والاستدلال وبالجملة الفكرة ، تسعمل في نيل كل واحد منها) ، (31).
4 ـــ السيرة والفكرة
في عرض ابن طفيل لفكر وحياة ابن باجة نقرأ السطور التالية :
( . . ولم يكن فيهم أثقب ذهناً ، ولا أصح نظراً ولا أصدق رويةً ، من أبي بكر بن الصائغ . غير أن شغلته الدنيا حتى اخترمته المنية قبل ظهور خزائن علمه ، وبث خفايا حكمته . وأكثر ما يوجد له من التآليف ، إنما هي كاملة ومجزومة من أواخرها ، ككتابه في (النفس) و(تدبير المتوحد) ، (32)
ويضيفُ ابن طفيل انتقادات أخرى لأسلوب ابن باجة المفكك عادة ، ونستطيع أن نضيفَ إليه بأنه أسلوب غامض ومتقطع ومتكرر وهو يغزلُ على معاني أرسطو وكتبه ، ولكنه أيضاً يتوغلُ في قضايا عميقة رابطاً بني الأفكار العامة حو العقل والحياة الاجتماعية ، متجنباً الغيبيات ،محللاً نسيجَ الوعي بشكل فكري ، مقترباً من ربطهِ بشبكة الحياة الاجتماعية ، مبرزاً صوتَ المثقف المعارض لغيبية الصوفية ، (33).
إن كل هذه الجوانب السلبية والإيجابية في أسلوب ووعي ابن باجة تجعله بداية للفلسفة الأرسطية العربية وهي تظهرُ بشكلٍ مدرسي تلخيصي لمنهجية أرسطو ، لكنها تضعُ أساساً للقراءة الموضوعية للطبيعة والمجتمع اللذين غرقا في التبعية لما وراء الطبيعة ، وبهذا فإن تعبير ابن طفيل عن ابن باجة بأنه شغلته الدنيا ، يمكن أن نأخذه كتعبير عن انقطاعٍ مفاجئ لحياته قبل أن تتاح له الفرصة للتعبير ، ويمكن أن نأخذه كشكلٍ تعبيري للصراع بين توجهات ابن باجة العقلانية وتوجهات ابن طفيل الصوفية المنقودة والمرفوضة لدى ابن باجة ، وهذا ما دعاه لنقده بتلك الطريقة .
إن ابن باجة وهو يشكلُ مثل هذا الوعي العقلاني متجاوزاً النصوصية الدينية المحافظة مقدماً للنصوص الدينية رؤية أخرى ناقدة لبذخ أهل الحسب ، وعبر الاستشهادات من القرآن والحديث النبوي ، ورافضاً من جهة أخرى الرؤية الصوفية ، وعبر هذا الحفر في الوسط الاجتماعي المرئي المدروس التي تظهر نوابضه وسببياته من داخله ، لا من الاتصال بالعقل الفعال والفيض من النفس الكلية ، يكونُ قد شكل طريقاً مغايراً لابن طفيل الذي سيعلي من الشطح الصوفي كتتويج للمعرفة ، ويكون قد مهد السبيل لابن رشد كي يعمق هذا المسار الفكري وبشكل واسع ومتين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الاسلامية الجزء الثالث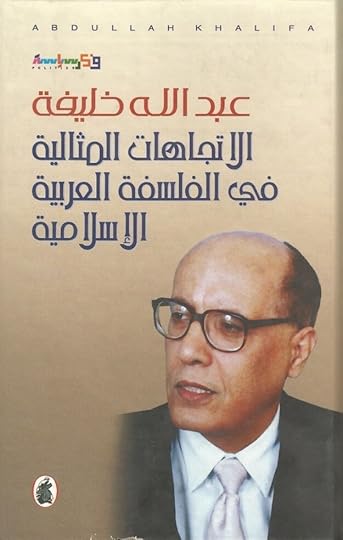
المصادر :
(1): (تدبير المتوحد ن ابن باجة ، سراس للنشر ، 1994 ، تونس ، ص4).
(2): (المصدر السابق ، ص 6).
(3): (المصدر السابق، ص8).
(4): (المصدر السابق، ص .
(5):(المصدر السابق ، ص 9).
(6):(المصدر السابق، ص9).
(7):(راجع فصل الفارابي في هذا الكتاب ، فقرة المدن الفاضلة).
(8):(تدبير المتوحد، ص 9).
(9) : (اقرأ في ذلك فصل ابن المقفع في الجزء الثاني من هذا المشروع)
(10):(راجع فصل ابن رشد ، في هذا الجزء).
(11)،(12): (تدبير المتوحد ، ص 10).
(13):(المصدر السابق ، ص 12 . وكان تعبير (النوابت) القدحي قد استخدمه الجاحظ ضمن من استخدمه لتتنديد بالجماعات الدينية المتشددة ، راجع : فصل (من أفكار الجاحظ الفكرية والفلسفية) في الجزء الثاني من هذا المشروع، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ، 2005).
(14): (المصدر السابق ، ص 13).
(15): (المصدر السابق ، ص 20).
(16): (المصدر السابق ، ص21).
(17): (المصدر السابق ، ص 22).
(18): (المصدر السابق ، 22 ).
(19): (المصدرالسابق ، ص 24).
(20): المصدر السابق : ص 25) .
(21): (المصدر السابق ، ص 26) .
(22) : (المصدر السابق ، ص 28 ) .
(23) : ( المصدر السابق ، ص23 ).
(24): (المصدر السابق ، ص 29 – 30).
(25): (المصدر السابق ، ص 31 ).
(26) : (المصدر السابق ، ص 40) .
(27) : (المصدر السابق ، ص 42 ) .
(28) : (تاريخ الفلسفة الإسلامية ، مصدر سابق ، ص 322) .
(29) : (تدبير المتوحد ، ص 41).
(30) : ( المصدر السابق ، ص 43 ) .
(31) : ( المصدر السابق ، ص 57 ) .
(32) : (وضعت دار النشر فقرة ابن طفيل في المقدمة).
(33) : (فتنكب ابن باجة عن هذه الاعتبارات ، وبين أغاليط الغزالي ، واعتبر دعوته للتصوف والعزلة خداعاً للناس وتضليلاً ، لأن العالم العلوي ، لا ينفتحُ للمتصوف المتنسك الواهم ، وانما يطل عليه العقل الباحث عن كمال ذاته ، المصدر : أهلا الفلسفة العربية ، مصدر سابق ، ص 653).
December 9, 2023
شخصياتٌ لا مبادئ ـــ كتب : عبدالله خليفة
تتفتق وتتشظى التنظيماتُ السياسيةُ في اللحظات الاجتماعية العسيرة على الشعوب، ليس لتزرع تطوراً جديداً نوعياً، بل لتعبر عن طموح قادتها، ورغباتهم في تملك التنظيمات والزعامات!
تتشابه هذه اللحظات والتشظي بما حدث لتنظيمات الخوارج وغيرها في العصر الوسيط حيث راح زعماء الفرق يؤكدون ذواتهم الفردية الحادة وكلٌ منهم له طموح يقومُ بشق التنظيم ويؤكد تباينه الفكري المميز عن صاحبه الذي كان وهو لا يحمل شيئاً من ذلك.
فعرف المسلمون وقتذاك آلاف الفرق السياسية والدينية بحيث كان هذا نذيراً بالانهيار العام.
القوى ما قبل الرأسمالية غير قادرة على الصعود للعصر الحديث، وغير قادرة على الانحياز للطبقات الحديثة، التي لها رؤى وبرامج تاريخية، وهي حالات الشرق خاصة الذي يعيش مخاضات الانتقال.
الخطوط العريضة التي صنعها الغرب والتي تبلورت في الخطوط الاشتراكية والرأسمالية المتعددة، قبلها كان ثمة مخاض طويل للفوضويين والقوميين وأصحاب العنف والنخب المغالية بفرديتها وللروحانيات ذات الشطط، لكنها كلها ذابت عبر قرون التطور وتبلور المجتمعات وظهور الاصطفاف الاجتماعي بين البرجوازية والعمال.
هنا نجدُ استمراريةَ عقليات القرون الوسطى وقيام كل نخبة بصنع تنظيم، معبرةً عن طابع الاقتصاد غير المتبلور، وتضخم الفئات البرجوازية الصغيرة والحرفيين والموظفين، وعدم وجود صناعات مركزية خاصة كبرى.
حين يقوم أي تنظيم من هذه التنظيمات الذاتية غير الموضوعية لن نجدَ فلسفةً وراء هذه العملية الانشقاقية، والفلسفةُ الجديدةُ هي المبرر الموضوعي لنشوء تنظيم مختلف، بمعنى انه قامَ بذلك لأنه يعبرُ عن رؤيةٍ جديدة للوجود والمجتمع، وعن صعودِ طبقة مختلفة أو تكوين اجتماعي مهم في الحياة له أسس في الاقتصاد والحياة الاجتماعية.
الانشقاقُ وهو فعل تفتيتي للناس، وإذا كان بلا رؤية فكرية معبرة عن غليان اجتماعي ذي تراكم معرفي سياسي طويل مُبرر يكونُ نقيضهُ تمزيقاً مدمراً.
هنا تكون طموحات الأفراد واختلافاتهم ورغباتهم في الصعود والظهور والحصول على مغانم ما، هي أساسُ الانشقاق، وبالتالي فإنها تزيد المجتمع اضطراباً وتوسع الخلافات غير الموضوعية بين جماعاته وأفراده.
وغالباً ما يحدث ذلك في التنظيمات الدينية التي لم يكن لها أساسٌ شرعي من البداية، حيث قامت خلافاً لرؤيةِ الإسلام التوحيدية التجميعية الشاملة السياسية للمسلمين، التي لم يكن غيرها سوى تفتيت، وقد بدأتهُ المذاهبُ الكبرى المتحولة من فقهٍ شرعي متنوع مطلوب في فهم العبادات والمعاملات، إلى قفزة سياسية تفكيكية للجموع من قبل المسيسة المنتفعة، وعبر تكوين الفسيفساء التي بدأتْ من كبريات الفرق حتى ذراتها الصغيرة الذائبة في الغبار السياسي للتاريخ.
وكانت هذه العمليات تعبر عن اقتصادات مفككة، تزداد اهتراءً وذوباناً في المناطقية والمحليات الضيقة، ويمكن ملاحظة المفارقة المأساوية الكبرى بين ضخامة دعوة التوحيد وتشكيلها الامبراطورية وعقليات الفرق والطموحات المريضة لقادتها، وتشكيلها ذلك الغبار الاجتماعي السياسي!
وفي هذا العصر راحت الأمم تبني الاقتصادات الكبرى وتجمع الملايين وتحتاج إلى أحزاب كبرى تعبرُ عنها، وتقرر سياساتها التحويلية، وسياسات التوحيد العالمية تتصاعد بشكل خطر ينذرُ الدولَ الصغيرة التي تقل عن ثلاثين مليونا بالخروج من الخريطة الجغرافية السياسية العالمية.
هذه توحيديةٌ معبرةٌ عن وعي الصناعة، وتلك تفكيكية معبرة عن عقلياتِ الدكاكين.
نجدُ ملامحَ الأحزاب الرأسمالية تأخذُ بُعداً كونياً حين تتجمع أحزاب اليمين الغربية معبرةً عن سياسات وتحتدم بينها الخلافات تعبيراً عن صراعات الأسواق والأمم ولكنها تضع خطوطاً عريضة لدول كبرى، تماماً كما تفعل الأحزابُ الاشتراكية لكن من مواقع اجتماعية أخرى، ولمصالح قوى العمال والمنتجين والرأسماليات الوطنية المطحونة من صراعات العمالقة.
ولهذا نجدُ في بلداننا بعد زمنٍ يسير من تشكل الجماعات السياسية ان عددها زاد عن أعداد أحزاب الدول المتقدمة وهي لا تضم سوى بضع عشرات من الأفراد، وتغيبُ عنها أي رؤى فلسفية سياسية، والعديد من قادتها يريد البروز ولا يقدر على تغيير أي شيء في الواقع، ودع عنك أن يكون قادراً على تغيير الظروف المادية للجمهور.
كما أن هذا دليل على التضخم الذاتي، وعدم وجود دراسات جدية للأوضاع العامة وتشكيل رؤى نقدية تحويلية خاصة بأصحابها.
ثمة فرق هائل بين الفقاعات السياسية وبين التنظيمات التي تتجذر في الأرض والناس وتطرح سياسة تحويلية يلتف الجمهور حولها وتأخذ طريقها للتنفيذ، وتصعيد مجتمع المالكين والعاملين المتصارعين بشكل حضاري.
December 8, 2023
في «حارة العدامة» تكتظ الأجساد بعضها ببعض مسكونة بالحب والسحر!
«ساعة ظهور الأرواح» للأديب البحريني عبدالله خليفة قراءة للرواية
رضا الستراوي*
الأديب البحريني عبدالله خليفة، هو أديب وروائي وكاتب متمرد على واقعه، منحاز لطبقة الفقراء والعمال والفلاحين في أكثر أعماله التي أصدرها ضمن مشوار تاريخه الحياتي والأدبي.
فمنذ أواخر الستينيات من القرن الماضي كانت أول تجاربه في القصة القصيرة والرواية وأيضا، كاتباً في مجالات النقد والبعد الفلسفي في قراءته للتاريخ، وهو المجد في مجاله السردي على مدى سنوات ومشواره الأدبي، بين رهان واقع متأزم مؤمن به ضمن منظور انشغالاته بالإنسان وحركة المجتمع.
فالكثير من إبداعاته هي نتاج عصارة عمر طويل قضاه في الكتابة وفي الابداع الأدبي والثقافي.
رحل الروائي الأديب عبدالله خليفة عن الحياة في يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2014، بعد مشوار احتضن فيه الأدب وشجع الشباب على الالتزام به.
وفي معظم كتابته نقرأ: ان عبد الله خليفة لم ينحاز لطبقة أكثر ما انحاز فيه لطبقة الدنيا من الفقراء والفلاحين والعمال، وما قرأته في روايته: «ساعة ظهور الأرواح» الصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت – لبنان 2004 م.
عن الرواية:
تحدث الرواية عن حارة )العدامة) التي جسد فيها الروائي عبدالله خليفة ضياعها، حيث كانت حارة العدامة مستنقعا زيتيا غير مكتشف، يبحث فيه السحرة والمقاولون عن كنوز الأجداد الضائعة، حيث يتعاملون ويتصلون بقوى غربية في شتى أنحاء الكون لمساعدتهم في العثور على الكنوز وتغيير طبيعة الإنسان في حارة العدامة، لكن كانت هناك قوى أخرى غزت العدامة وأحكمت قوتها على المستنقع وحبست الأرواح في الكهوف والحصالات بعدما تمكنت من إعادة تشغيلها بصورة مختلفة.
الفكرة في بناء الرواية:
لقد درج الأديب الروائي البحريني الراحل عبدالله خليفة في بناء أعماله الأدبية في قالب واقعي، منحاز فيه إلى الفقراء والمعوزين، من العمال والفلاحين، فالكثير من قصصه القصيرة حملت هموم هذه الشريحة واقفاً على صورٍ من حياتهم، ففي القصة القصيرة نرى هذه الواقعية جليت بمعاناة هذه الشرائح المجتمعية، ففي البحر صور للبحار المنهك وفي العمل نرى العامل المطحون بنوبات العمل اليومي، وفي الزراعة نرى الفلاح بين حراثة الأرض وبين الدين الذين يطلبه منه الاقطاعي (صاحب المزرعة).
وهذا النهج اتبعه الأديب عبدالله خليفة في قصصه القصيرة ورواياته، وخير شاهد ما برز في روايته «ساعة ظهور الأرواح».
وبرغم ما يمتلكه الروائي من أسلوب واقعي في بناء أعماله الأدبية تعتبر هذه الرواية من الروايات التي أثار فيها الروائي أسلوب الخيال الشاعري الواسع.
الخيال وتجسيد الصور الشعرية الواقعية في الرواية :
بأسلوب شاعري ولغة مشحونة بالهم المجتمعي مستحضرا في احداث الرواية ثيمة الاسطورة، مستكشفاً الروائي عبدالله خليفة علم المعدومين والفقراء والمهمشين في المجتمع، بأسلوب عجائبي لا ينفك عن الاتصال بالواقع الذي يكشف من خلاله عبدالله خليفة عن الكثير من مثالب المجتمع.
فبين (يوسف) الفتى الأبيض و (جوهر) صاحب الجسد الأسمر النحيف مفتول العضلات، و(الشيخ درويش) تكتظ اسنة الرماح الواقعة بين جيلين، جيل يوسف الشاب الحلو وجوهر الشاب الأسمر، اللذان يتوافقا في العمر، وبين الشيخ درويش صاحب البخور والأحجبة والذي يبعد عمره عن يوسف وجوهر تاريخاً وعمراً، فهو الذي يصنع المعجزات الروحية ويستحضر الأرواح ويعمل الأحجبة ويداوي بشعوذاته ضعاف العقول من خلال إيهام مرضاه بعمل تحريك الأرواح ومن خلالها يتم علاج مرضاه، في حارة العدامة وهو المكان الذي تكتظ فيه الأجساد في بيوت بنيت من الطوب وسعف النخل والجريد.
وفي ظل هذا الصراع يكبر يوسف المدلل الحلو، ليصبح تاجراً، بل اقطاعياً يستغل الآخرين في محبة ومهادنة يوسف الذي أصبح من كبار العدامة، والذي التف حوله الجميع يتقدمهم (الشيخ درويش) الذي همه البحث عن الثروة والكنوز المفقودة.
العدامة أرض مباركة:
في توظيف الاسطورة والبناء التخيلي استطاع الروائي عبدالله خليفة ان يجعل من روايته ساعة ظهور الأرواح ثيمة خاصة ذات نكهة تدفقت الوانها من خلال تحريك ابطال الرواية بلغة شعرية، كيوسف وجوهر والشيخ درويش وزهرة وأبو سمرة ومريم صاحبة يوسف وشماء التي هربت في ليلة عرسها من ابو سمرة العجوز المتصابي) زير نساء العدامة).
ومن خلال هذا السرد المشحون بسحر التخيل يتضح لنا أن الروائي عبدالله خليفة قد اشار اشارة واقعية اهدتنا لمفهوم ضياع (العدامة).
هي العدامة التي هي مجموعة من الأكواخ المتراصة بعضها ببعض، صاحبة المستنقعات التي هي كنز كبير لأصحاب الثروة والاقطاعيين والسماسرة، فهذه الأرض في باطنها الزيت غير المكتشف، الذي اثار شهوة المقاولين والسحرة وقطاع الطرق والاستغلاليين في البحث في باطن العدامة.
فهي كنوز الاجداد المسلوبة والضائعة، فتهاتف التجار واصحاب الثروات هي مسببات تغير وجه العدامة إلى (حارة) بها كنوز كبيرة غير مستكشفة، فلا يزال المستنقع الفضي يثير شهوة جشع الإقطاعيين والتجار.
حلم كبر ومع هذا الحلم كبرت احلام سكان العدامة فتصارعوا واشتد خناقهم بحثا عن الثروات التي هي مدفونة في باطن العدامة.
فلم تعد الطيبة لها مكان في قلوب ساكني العدامة عندما تحول إلى ربوت الكتروني يثير شهوة السراق في سرقة باطن العدامة، أي (الحي) الجديد.
عالم يسكنه حلم فنتازيا الأحلام الأسطورية:
في أسلوب الكاتب عبدالله خليفة في تحريك وتوظيف شخوص هذا العمل يتضح لنا انه التزم بالواقعية كمفهوم طبقي عبر توظيف ابطال الرواية من العتالين والعمال والفلاحين والمعدومين من طبقات المجتمع، في مقابل صاحب رؤوس الأموال كالتجار والأقطاعين الذين يمتلكون الثروة فيخضعون ابناء العدامة كمخدومين يقومون بتنفيذ ما يريدونه مستغلين ضعفهم وفقرهم وعازتهم للمال.
بهذا الأسلوب حرك عبد الله خليفة أبطال روايته في مقابل المشعوذين الذين يتاجرون بعقول البسطاء، فيلجئون لهم في شؤون حياتهم.
ولم تخل الرواية من الأسلوب الغرائبي الساحري الذي امتلكه الروائي عبد الله خليفة من خلال تجاربه الطويلة في عالم السرد.
بين رواية عبد الله خليفة ورواية توفيق الحكيم:
تتشابه رسالة رواية ساعة ظهور الأرواح برواية الكاتب المصري توفيق الحكيم في روايته المعنونة الشهيرة «عودة الروح»، حيث الصورة في المعنى واحدة عند توفيق الحكيم وعبدالله خليفة.
مفهوم لبعد رسالي واحد في احياء الأرواح الميتة عند توفيق الحكيم والجمع بين الروايتين ساعة ظهور الأرواح وعودة الروح في مغزى مفهوم الحياة من ناحية جدلية وفلسفية، بما تحمله من احداث .Top of Form
ولتقارب شخوص رواية عبد الله خليفة بشخوص رواية توفيق الحكيم في «عودة الروح» تتوحد احداث رواية ساعة ظهور الأرواح التي تدور احداثها في حي «العدامة» وهي أحد الأحياء التي يسكنها الفقراء، وأيضاً في عودة الروح للحكيم نرى إنه يسرد احداث شخوصه من خلال ما يدور من احاث في بيت مليء بالشخصيات وكل له حكايته، في صراع يقترب من الحب ومن معاناة الحياة.
حيث إن الحكيم يتحدث عن الشعب برومانسية عالية، وعبد الله يتحدث ايضاً عن الشعب ولكن بواقعية معاشة اهل ساكني العدامة.
ملامح الحدث.. صور أخرى!
برغم ما شدتني الرواية واندمجت مع صور احداثها الا انها اربكتني خلال القراءة، لأن الراوي عبدالله خليفة استطاع ان يوظف الصراع الطبقي لكنه في جانب آخر أوغل في الصورة الشعرية واللغة العالية في بناء أحداث الرواية، فسحر الكلمات وتدفقها اصابت ذاكرتي بما يفهم «**لالتباس»، فعالمه بين واقعية وبين سحر خيالي لم يكن في ادبه الآخر.
قد تكون هذه الرواية تجربة مغايرة إلا إنها عالم ميتافيزيقي خيالي غلب عليه لغة السحر البلاغي.
خلافا عما كان سائداً في أعمال عبدالله خليفة التي عرفت بواقعية مفرطة لا غرائبية فيها كما هي في ساعة ظهور الأرواح، التي اعتمدت على الواقعية غير المتعارف عليها في ادب خليفة.
ومن دون إضافة العالم الغرائبي لشخوص أفعال أبطال الرواية، ففي الغرائبية أصبح القارئ بين سندان واقعية مفهوم العمل وبين ميتافيزيقيا الخيال الحالم لمعنى الغرائبية في تحريك الأحداث من خلال الصراع الذي أبرزه الروائي على ألسنة ابطال الرواية.
لأن الأسلوب جعل من القارئ متكأ في إكمال العمل، فالصعوبة في التمسك بكل حدث من خلال ابطال الرواية، يربك القارئ.
والجميل أنني اكتشفتُ عالم عبد الله خليفة وتنوع لغته السردية من خلال نتاجه السردي وبالخصوص قراءتي لرواية ساعة ظهور الأرواح ما عكس داخلي من أبعاد الصراع الطبقي في المجتمعات التي اثارها الرواي، وكيف كان اهل البحرين قديما يعيشون، وكيف كانت تبنى منازلهم وماذا يعملون، فعرفت ما يرتبط بالفقراء وبعالم اصحاب الثروة، وعرفت أنني امام عمل روائي شدني قراءته وشدني على الاطلاع عن عالم عبدالله خليفة القصصي والروائي.
فالبحر والنخل وابناء القرية وابناء المدينة هي عوالم شخوص أعمال عبدالله خليفة.
فالرواية لديه هي بعد ادبي متكامل، لا يمكن لأي قارئ ان يفقد البوصلة من خلال الاطلاع على أعماله الأدبية.
وتظل الصورة متكاملة الحدث في أبعاد أخرى، صور يومية نراها في حياة الناس وانشغالاتهم.
*طالب بجامعة البحرين – قسم الإعلام
** الالتباس
December 2, 2023
العقل والحرية
العقل والحريــــــــــــة
1
العقل هو الثمار الفكرية الصائبة التي تنتجها القوى الجماعية والأفراد خلال الفترات والحقب والتي تستفيد منها الأجيال، وتوظفها للمزيد من التطور والحرية.
وقد وقع العقل في الجزيرة العربية أسير التكوين الطبيعي القاسي وأسير البنية الاجتماعية التي تكونت في قيود هذه الطبيعة.
ولم تستطع الحضارات القديمة في ما قبل الإسلام أن تنتج نهضة جزيرية عربية مترابطة متكاملة، في حين إستطاع الإسلام ذلك لقيادة مدنه الحجازية إستيعاب العناصر النهضوية للشمال العربي في مبنى تحويلي عربي عالمي.
فيما بعد مكة والمدينة لن تظهر مثل هذه المدن التحويلية النهضوية الشاملة. وعادت الجزيرة العربية لإمكانياتها الرعوية والمدنية المحدودة.
إن العناصرَ الجوهريةَ في العقلانية الإسلامية هي قيام العقل النقدي بقيادة طليعة الجمهور في أعمال نضالية متدرجة وإشراك الجمهور في المنافع الاقتصادية والتطور الثقافي، بالمواد الفكرية والاجتماعية السائدة وقتذاك.
الإسلام كثورة أقام سلطة ليس ثمة بينها وبين الناس حواجز، قام بتوزيع أملاك الغزوات لمنع تركيز المُلكية، أي قدم جملة مفاتيح لدولة غير إستبدادية، وهذا الوضع تغير بعد الفتوحات والإنتقال للشمال العربي.
عنصر التجار الأحرار المتحالف مع الفقراء، شكَّلَ تلك النهضة، ولكنها إنساحت خارج الجزيرة العربية أكثر مما تكرست داخلها.
ولهذا فإن التراكمية العقلانية لن تكون من نصيب الجزيرة العربية، بل سوف تظهر في المدن الجديدة كالبصرة وبغداد والقاهرة.
في الجزيرة العربية فضاء جغرافي واسع، لكن الحرية صعبة، لأن تاريخَ البداوةِ المديد خلق سيطرات كثيفة: فحتى المركزية التي شكلها الإسلام لم تستمر وظلت العاصمة الدينية للمسلمين رمزاً غير محمي في كثير من الأحيان.
إن العقل كأرث فكري وقوانين ومؤسسات سياسية مدنية يحتاج إلى مدنٍ وإلى مدينة مركزية على الأقل، لكن هذا لم يتوفر للجزيرة العربية بعد قرن من الفتوح. فمع تراكم الثروة في بلدان الشمال العربي تفاقم الفقرُ في الجزيرة وخاصة في نجد والبحرين وعمان واليمن. فهل ظهرت إمكانيات للحرية؟
2
كان إنتاجُ الجزيرةِ العربية الفقيرة عبر تلك الإقاليم(اليمن والبحرين ونجد وعُمان) هو خلق التمردات والثورات المنقطعة عن خلق التراكمات الحضارية.
لماذا كانت الثورة منقطعة عن العقل؟ لماذا لم تشكل تجارب تراكمية باقية ومفيدة للقرون؟
لقد إعتمدت التراكمية النقدية النهضوية في قلب المدن العربية الإسلامية وفي عالم الخلافة على فئات وسطى من التجار والمتعلمين والحرفيين، وهي القوى التي شكلتْ المدارسَ والتيارات الفقهية والمنطقية والثقافية والفلسفية، وهي التوجهات التي وقفتْ وسطاً بين النظام الإقطاعي الحاكم بخلفائهِ وأمرائهِ وجواريه وبذخه وتمزقاته الكثيرة فيما بعد، وبين القوى الخارجة على القانون الداعية لإنشاء أنظمة خلافة بديلة، وشكلتها في الصحارى، وهي لم تبدلْ نظامَ الخلافةِ الإقطاعي بل جعلتْ من أمرائِها خلفاءَ تفتيتٍ وفقر مدقع.
من هنا كانت الصحارى في الجزيرة العربية هي الملاذُ لهؤلاء وهو أمرٌ كرّسَ الوضعَ المتصحر للعقل في هذه المنطقة الخليجية، وأغلب تلك الفرق قامت على النصوصية الشديدة.
في المجتعات خارج الجزيرة العربية حدثت تطورات خارج القبلية، وحدث تفكك لهذه المباني الاجتماعية، ولكن في الجزيرة العربية بقيت هذه القبلية، ولم تؤدِ تياراتُ التمرد من خوارج وقرامطة وزيدية إلى بلورةٍ مدنية إلا حين إنهارتْ هذه الفرق أو تحولت إلى إجتهادات أخرى.
إضافة إلى عدم التحول هذا تكرست المحافظة الاجتماعية عبر تهميش النساء وهيمنة الأبوية، وسيطرة النصوصية الشديدة.
وجاء تطور المذاهب الإمامية متدرجاً عبر قرون، وبعد فشل الزيدية ثم القرامطة فإن الإثناعشرية قامت بالتطور المديد والتغلغل الاجتماعي في بيئة الفلاحين من جنوب العراق حتى البحرين.
وجاءت المذاهب السنية المعتدلة كومضاتٍ في هذه الأثناء وتزايدت منذ القرن الثامن عشر الميلادي وبأشكالٍ قبليةٍ عسكرية قفزتْ نحو السيطرة على المواقع التجارية والمرافئ.
وضع المذهبُ الجعفري أسسَ نمو الحياة الريفية في المدن الساحلية الشرقية البحرينية بالمعنى القديم، ولكن في هذه الأثناء جاء المذهب الحنبلي بتطوراتهِ ومخضاته من الشمال العربي عبر السلفية الجهادية وتغلغل في الجزيرة العربية وفي نجد خاصة أي في الأقاليم الصحراوية وشكل مناخاً دينياً شديد المحافظة، وبهذا حدث تناقض بين مستويين إجتماعيين وفقهيين مختلفين كثيراً.
علينا أن نقول بإن الإثناعشر تمثل في بعض ما تمثله تقاليد الفلاحين الإحيائية الضاربة بجذروها عبر آلاف السنين، الممتدة من التموزيين مروراً بالمسيحين حتى المسلمين، وهي إعطاء قيم الأرض والتضحية حالات إحتفالية فلاحية قوية، وفي المذاهب السنية الأقرب للبدو والتجار ثمة إنفصال عن هذا الموروث، والاعتماد على النصوصية العقلية مثل الشيعة في هذا المجال كذلك.
يمكن أن نرى في قبيلة عبدالقيس المسيحية قبل الإسلام المسلمة بعده هذا التضفير بين الجذور الإحيائية ومصالح الفلاحين وإحتفالية الأرض المتخلصة من الوثنية كذلك والمتمايزة عن الارستقراطية الحاكمة البدوية.
لكن كان الصراع الاجتماعي السياسي هو الأساس، ومثلت أملاك الفلاحين وأهل المدن مطمعاً للبدو وهي حالة عيش ضارية طالما اعتمدتها القبائلُ البدوية الغازية في معيشتها، ولكنها هنا اتخذت أشكالاً دينية. وهذه أدت لمفارقات وسجون إجتماعية تاريخية للغالبية من المنتجين الشعبيين.
وعوضاً عن أن تنتشر في الجزيرة العربية ثمار الشمال النهضوية جاءتها الإشكاليات الفكرية له، وثمار هزيمة التطورات العقلانية الفقهية.
3
إنني أقدمُ هذا التحقيبَ الاجتماعي التاريخي بغرضِ التمييزِ هنا بين الإسلام كثورةٍ فتحتْ الآفاقَ النهضوية للعرب وللمسلمين وبين الإسلام كعقيدةٍ قامتْ من تشكلِ أبعادٍ غيبيةٍ ميتافيزيقية وتجسيدات تاريخية سياسية وعبادات ومعاملات بناء على ذلك المنظور الغيبي، فكافةُ حركاتِ الإسلام تبدو نتاجاً للغيب، فيما هي كذلك ثورةٌ إجتماعية بظروفِ البداوة العربية في الجزيرة وقتذاك.
ولكن هذا الفصلَ بين المنظورين لم يكن متيسراً عبر العصور، ولهذا فإن الحركات التمردية كانت محافظة، ولم تقم تمرداتها بشيءٍ عميق يمكثُ في الأرض، بل على العكس أحدثت القلاقل، نظراً لأنها لم تأخذ العناصر النهضوية في الإسلام وتشتغل عليها، وهو الأمر الذي قامت به الحركات الفكرية في المدن الإسلامية دون أن تطوره ليكون حركة تغييرية شعبية.
وعمليات الخلخلة التي قامت بها للعناصر المحافظة في الإسلام لم تُحدث نقلات، فحدث فشل كبير لها، قامت على أثره المذاهب وخاصة المذهب الشيعي والمذهب السني في شرق الجزيرة العربية ، بملء الفراغ المترتب على ذلك الزوال لحركات التمرد.
هذا لا يعني عدم وجودهما من قبل لكن نقصد هنا الانتشار والاكتساح.
اعتمد المذهبان على المبادئ العامة المحافظة عامة، أي لم يطرحا مسائل الثورة وتبديل حال العامة الفقيرة، ركزا على الشعائر والعبادات والفقه الخاص بكل منهما. وخلقا في ذلك تطوراً إجتماعياً مديداً رغم الغزوات والصراعات.
4
أدت التطورات السياسية في العصر الحديث إلى إنتصار الحنبلية السياسي والاجتماعي في أغلبية الجزيرة العربية، وتحولت لغة التمرد للفرق السابقة المهتمة بالغزو وثماره الاقتصادية إلى هذه الفرقة الحنبلية وشكلت جموداً إجتماعياً كبيراً لأغلبية الجزيرة العربية، فيما حُبست مدن الشيعة في مناطق معزولة أو متقطعة أو متنابذة، حاولت على مدى عقود أن تنفتح على الخارج.
كما قلنا ذلك تشكل من خلال قفزات القبائل البدوية ذات الطابع العسكري، فيما كانت المناطق الريفية ذات إستقرار طويل الأمد. ولهذا حدثت قفزات القبائل البدوية نحو المناطق الساحلية بسرعة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين.
يمكن ضرب المثل بقبائل آل ثاني وآل خليفة وآل صباح، وتتعدد طبيعة هذه القبائل المهاجرة حيث يغلب على بعضها الطابع التجاري المدني كآلخليفة وآل صباح بينما آل ثاني يغلب عليهم الطابع البدوي.
ـــــــــــ
مصادر
* ولقد كان طبيعياً أن تتأثر قطر بهذا المذهب نظراً للصلة المستمرة التي تجسدت في كون قطر ذات حدود برية مع الدولة السعودية التي انطلقت منها هذه الدعوة، ولا يزال القطريون يكنون احتراماً بالغاً للمملكة العربية السعودية باعتبارها موطن الإمام محمد عبد الوهاب مؤسس الوهابية، ولا غرو، فإن قاسم بن محمد آل ثاني مؤسس دولة قطر نفسه كان سلفياً وهابياً، وكان الشيخ رشيد رضا يعلم السلفية لأهالي قطر، كما قام بنفس المهمة أناس آخرون في كل من البحرين والهند، وذلك في محاولة للتصدي لموجة التبشير التي أطلق عنانها في البحرين بأيدي مبشرين من الأمريكيين والإنجليز على حد سواء.
December 1, 2023
مراحل تطور (البرجوازيات) العربية ــ كتب : عبدالله خليفة
حدثت تعميمات لدى الباحثين العرب تجاه الفئات المتوسطة، عبر سلق تعبير (الطبقة البرجوازية)، فالفئات المتوسطة في العصر العربي الكلاسيكي، كانت في حالة تبعية شبه كلية للإقطاع، في حين إن في الزمن المعاصر تتشكل في حالات متعددة تبعاً للتبعية أو الإنسلاخ من الإقطاع.
عند العديد من المفكرين والباحثين المعاصرين هناك التعميم، وسواء كان ذلك في الفكر الفلسفي كما عند مهدي عامل، أو كان في التأريخ الثقافي كما عند الدكتور سيد النساج في مصر في دراساته عن القصة القصيرة المصرية خاصة.
لا بد من تحقيب قراءة الفئات الوسطى، بمعنى أن نعرف إن لها حقباً، مرتبطة بتطور قوى الإنتاج وعلاقاته.
في الفترة الحديثة الأولى كانت مرتبطة بالاستيراد، ولهذا كنا نقرأ لمفكريها شطحات نهوضية كبيرة، فشبلي شميل أو إسماعيل مظهر وسلامة موسى يدعون لحداثة غربية ناجزة، وهي حداثة التاجر المستورد، الذي لم يشكل قوى إنتاج صناعية عربية، والذي يحولُ النهضةَ إلى استجلاب للبضائع الفكرية ويعتقد إنها تحلُ إشكال التخلف. إنها مرحلة رأس المال التجاري.
في البحرين نجد ذلك يتقارب مع فترة مثقفي هيئة الاتحاد الوطني، رغم إن استيرادهم كان أقل تطوراً من قرنائهم العرب بطبيعة الحال.
في الفترة الثانية والتي حدثت في البلدان العربية (المتطورة) حين لم يعد الاستيراد هو العلامة الميزة للإنتاج والوعي الطليعي، هنا حدث الانتقال من الاستيراد الكلي إلى الاستيراد الجزئي ونشوء بدايات التصنيع، والذي أرتكز على المرحلة السابقة، وزمن الحربين العالميتين اللتين ساعدتا على استنهاض كوامن الإنتاج، وفي هذا الزمن استطاع الفكر عبر طه حسين وأحمد أمين ومن ثم حسين مروة وغيرهم على إنتاج قراءات عربية إسلامية. إنها مرحلة رأس المال الصناعي الخاص – العام الأولي.
إن الفترتين السالفتي الذكر شكلتا ما نسميه بالنهضة الوطنية والتقدمية، رغم إن الكم النقدي ليس بمستوى الفترة الثالثة، لكن كان هذا الكم النقدي يتجه في كثير منه إلى قواعد الصناعة، ويمكن أن ندخل في حساب ذلك الأنظمة الوطنية التي تشكلت والتي وسعت الصناعات، وهي كلها فترة وجهت النظر العقلي نحو نقد الواقع والتراث، بمستويات متعددة ومقاربات مختلفة.
ثم جاءت المرحلة الثالثة الراهنة والتي اعتمدت على فورة صناعات الاستخراج، وخاصة النفطي منه، وهي مرحلة اعادت الاستيراد بقوة، سواء على مستوى الإستيراد من الغرب، أو إلى مستوى الاستيراد من الماضي العربي.
وهي صناعة إستخراج لا تغير جذور المجتمع السحرية والأمية لكنها تتنج مردوداً مالياً كبيراً.
ولم تعتمد على تطوير قواعد الإنتاج السابقة، بل أدت في العديد من البلدان إلى تحطيمها، كتصفية الصناعات الشعبية، أو تخريب الصناعات المؤممة، أو نقل المصانع الخربة الملوثة من أوربا الخ.. وهذه كلها أدت إلى صعود الطفيليات الإدارية الكبرى التي أفسدت الثقافة.
هنا نجد الوفرة النقدية في بعض البلدان لم تؤد إلى نهضة، إلا بشكل إستيراد الكماليات بصورة بذخية مدمرة.
الاستيراد الجديد هو الذي شكل الجماعات المذهبية السياسية، التي راحت تجتر ما قاله القدماء الجامدين في فهم الدين. إن الوفرة المالية هنا ساعدت على اعتقال العقل، في حين كان زهد طه حسين أو سلامة موسى أو حسين مروة أو جمال عبدالناصر أو عبدالكريم قاسم مشابهاً للتراكم النقدي المطلوب لدى برجوازية التصنيع الأولي وتقشفها.
إن المراحل التالية التي قد تستمر في الماضي أو قد تصححه، مرهونة بمدى تعزز مواقع القوى الديمقراطية في المجتمعات العربية، ومدى تحويل صناعات الإستخراج والصناعات الخفيفة إلى صناعات كبرى، وتغيير الهياكل السكانية المتخلفة.
والمرحلة الثالثة نجد تجلياتها الفكرية في النقل الآلي من الغرب والنقل الميكانيكي من التراث، وضخامة الاستيراد على الجانبين، فهنا راقصة مغنية بأحدث موضة وهناك مقنعة تخاطب القبور، شكلان متضادان يعبران عن أن القوى الشعبية لم تتمكن من السيطرة على الموارد وجعلها من إجل الإنتاج العربي.
لا بد من رؤية حلقات التداخل بين المراحل العربية الثلاث التي أسست النهضة منذ القرن التاسع عشر الميلادي.
لقد كانت مرحلة رأس المال الخاص والعام متداخلة، فهذان الرأسمالان الموظفان في الصناعة الخاصة والعامة، تصادما في المستوى السياسي، فكان صناعيو المرحلة التي وقعت فيها الانقلابات العسكرية يرفضون المشاركة في دعم الإنتاج، خوفاً من دعم هذه الأنظمة التي بدا فيها الواقع السياسي مقلقاً وخطراً على التوظيفات الرأسمالية.
إن عدم دعم الصناعيين لخطط التنمية التي طرحتها الحكومات العسكرية، بدا لهذه الحكومات العسكرية الوطنية بمثابة تآمر وحصار، ومشاركة في الموقف الاستعماري الرافض للتصنيع.
لكن الحكومات العسكرية من جهةٍ أخرى لم تعِ بأن التصنيع غير مرفوض غربياً لكن المرفوض هو التصنيع بيد الحكومات العسكرية، فهذا كانت له نتائجه الحربية والسياسية على خريطة المنطقة، ولو أن العسكريين سلموا السلطة لحكومات منتخبة لما كان الأمر كذلك.
وهكذا فإن التصنيع العام الذي ظهر بيد الحكومات العسكرية كان يمثل قطيعة مع التصنيع الخاص الذي تشكل بيد الرأسماليين الأفراد والشركات والبنوك الخاصة، واحتلال الحكومات للفضاء الاقتصادي كان من شأنه أن يرعب الرأسمال الخاص الجبان بطبيعته، وهذا ما أدى على المستوى الفكري إلى نهجين متضادين كلياً، فهناك الشعار الاشتراكي الحكومي، وهو بمثابة غطاء لفشل التعاون بين البرجوازية الحرة وبين الفئات الوسطى الحاكمة العسكرية، وهو بمثابة رد وإلغاء لدور هذه البرجوازية التاريخي، فتم إعدام وجودها من الثقافة والتاريخ، ولم يعد ثمة من فكر سوى فكر الاشتراكية الحكومية التي صُورت على إنها نهاية التاريخ الطبقي.
إن عدم القدرة على تشكيل تعاون بين هذين الرأسمالين كان يعني توقيف نمو بذور الوعي الديمقراطي العربي والإسلامي المنتج، وهو الوعي التحرري الموضوعي، الذي طلع بشق النفس، ولكن أدوات التحليل لديه لم تتطور ولم تتجذر، فظل نائياً عن الجدل وفهم تناقضات التطور الموضوعية.
فكان الجانب الثاني من الوعي المعبر عن الرأسمال الخاص، قد تعرض للتآكل فنرى طه حسين والعقاد وأحمد أمين وغيرهم يتوقفون عن درس ونقد الواقع، بينما كان الفكر الماركسي العربي يتوه في زفة الاشتراكية الحكومية، ويفقد أدوات التحليل بشكل آخر، فيذوب ذيلياً في هيمنة القطاع العام الدكتاتورية، والتي في تصوره كما في تصور العسكر، تلغي وتزيل الطبقات!
إن الفكرين الوطنيين المعبرين عن رأس المال العام والخاص، تصادما وعجزا عن التعاون، مثلما أن المصنع الخاص الصغير تعرض للإنهيار من العملقة الحكومية، والتي توجهت لهدم التصنيع الخاص، وترك الأشكال الأخرى كتجارة الجملة والمفرق والعقار والصرافة تعيش مؤكدة سيطرة الجوانب الطفيلية من الاقتصاد على الجوانب المنتجة.
وهكذا فإن الإنتاج على مستوى الصناعة وعلى مستوى الوعي، تعرضا للتآكل التدريجي، فالصناعة الخاصة تعرضت للحصار، والصناعة العامة تعرضت لسرقات البيروقراطية الحكومية المتنفذة، في حين كان الوعي الوطني الديمقراطي بمختلف أجنحته يتعرض هو الآخر للتآكل، لأنه هدم التصنيع الخاص الحر وأوقف النظر التحليلي الموضوعي في رؤية الاقتصاد، وراح يشكل قصوراً في الهواء.
إن القفزة التصنيعية الكبيرة كان لها نتائج هامة وعظيمة، وقد مثلت نقلة أخرى في دعم القاعدة الاقتصادية، لكن غياب الحرية والنقد ومجيء المشروعات بالقوة من الأعلى، وعدم ترابط التصنيع مع تغيير الريف، وانفصام ذلك كله عن تغيير الثقافة الشعبية والأسرة الأبوية، هذا كله أدى إلى توقف التصنيع العام عن دوره الثوري الواعد.
وعبرت الهزائم العسكرية وعدم القدرة على تغيير خريطة المنطقة لصالح الاستقلال العربي، عن عجز القطاع العام بصيغته البيروقراطية غير الديمقراطية، عن تشكيل النهضة والتحكم في المصير، فعاد القطاع الخاص للسيادة مع صراع شديد ضد العام، ومع تدخلات مالية أجنبية وطفيلية هائلة.
الشكلانية الدينية.. أنانية ــ كتب : عبدالله خليفة
هناك توهمٌ أن الألبسة والأشكال والمظاهر الخارجية تحل المشكلات كافة، فإذا لبست هذا اللباس ووضعت هذا الديكور على جسمك ونفسك فأنت بمنجى من كل شر، وأنت النموذج والقدوة.
لكن خطورة الأشكال أنها سهلة، وخادعة، وهي تغازل الجهل الجماهيري، وتنومه، وفي ذات الوقت تمتد أيدي بعضها لجيوبه.
لقد مرت على الأمم الإسلامية قرون طويلة من التجهيل سواء لدى (علمائها) أم عامتها، ونحن الآن في زمن التحديث لا بد أن ندرس كل هذا الزمن، ونضع قواعد دقيقة لتغييره.
وقد طبق السلف أحكاماً إنسانية ثرة كقول عمر بن الخطاب (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟!)، بمعنى أن الحرية سابقة على أشكال القيود كافة، وأن أي حدود وقوانين خاضعة لوضع الأغلبية الفقيرة.
وحين تركز في هذا الإنسان الفقير الذي دفعته حاجته المادية أو الجنسية لفعل شائن، فلماذا لم توسع نظرتك النقدية التحكيمية في هذه المؤسسات المغيبة عن الرقابة وتلك المباني البعيدة عن المحاسبة؟
في زمن الفقه التابع للحكومات كان للفقهاء والمشرعين عذرهم فقد كانت اسواط الدول واقبيتها جاهزة لابتلاعهم، فطبقوا أحكاماً نصوصية شكلانية، انتزعوها من بين لوحة كبيرة حية، لكن ما هو عذر الفقهاء في هذا الزمن وخاصة في الدول التي أعطتهم حرية التفكير، واستقلالية القول؟ بأن يركز على هذا اللص الفقير ولا يفكر في أوضاعه المعيشية، وعلى هذه العامة المحرومة في غرائزها، وهو ينبغى أن يكون مدرسة أخلاقية لها، تعرف حاجاتها وظروفها وتقودها للرقي عبر تغيير أوضاعها المادية.
فلا بد للمشرع من زيارة هذه الزرائب التي يعيش فيها الناس، وأن يوجه بصره القانوني لما يرفع من حياتها، وبعدئذ يستطيع أن يحاكمها في سوء تصرفها.
تقود الشكلانية الدينية إلى النظر للأحكام من دون الرجوع للظروف الشعبية، فيتوجه المشرع إلى الاهتمام بمصالحه لكون تغلغله في ظروف الناس ونقد القوى الاستقلالية سوف يمنع التراكم المالي في جيوبه، وسوف تنظر القوى السياسية له كنشاز، وكلما منع صوت ضميره، وفكر في نفسه، خالف دينه، وانفصل عن قاعدته الشعبية. المناخ الشكلاني الذي يعيش فيه بعض فقهاء هذا الزمن، يمثل زمن الطفولية في الفهم الإسلامي، حيث الحماسة للأشكال، وعدم اختراقها للوصول إلى المضامين، ولكنه أبضاً زمن تجميع المال بلا محاسبة أخلاقية، وزمن الشركات التي تتاجر في الدين وفي المسلمين لتجميع المليارات وترحيلها للغرب، وهؤلاء الفقهاء ينخدعون بالشعارات ولا يمشون فى أزقة المال ويدققون في شعاراتها وكيف تعامل الناس وأي أجور منخفضة وأي مساكن رهيبة تقدمها؟
توزيع الطبقات والفئات الإسلامية الحديثة ــ كتب : عبدالله خليفة
إذا كان أسلوب الإنتاج الإقطاعي الديني لم يتبدل منذ عمر بن الخطاب، منقلباً في الشكل مع تغير الحكام، صائراً مذهبياً بعد أن كان إسلامياً عاماً، فإن بؤرته الاقتصادية المركزية تقومُ على ملكية الدولة للثروة العامة، وعبر هذه الملكية تتحدد أنواع وأحجام الطبقات والفئات.
ولكن هل أدى العصر الحديث بشركاته وصناعاته واستعماره إلى تغيير جوهري في أسلوب الإنتاج؟ ألم تقلبه هذه التغيرات «الكبرى» كما يقولون إلى أسلوب رأسمالي؟
إن أسلوب الإقطاع – المذهبي، يتضمن إنتاج الثروة المادية، عبر الإقطاع الاقتصادي السياسي، وإنتاج الدين عبر المذاهب، ولهذا فهو يشمل كل البنية الاجتماعية، بطوابقها الثلاثة: الاقتصادية والثقافية والسياسية، وحين جاء الاستعمار حافظ على البناء الإقطاعي – المذهبى فى الدول العربية والإسلامية، فلم تنشأ الفئات الوسطى إلا من خلال فيض الإقطاع الاقتصادي المسيطر. ولهذا ظلت تابعةً له بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل وطني، أو بشكل قومي.
ولهذا وجدنا الاستعمار يكرس حكم الأسر والأفخاذ القبلية والطوائف، وحين جاءت الأنظمة الجمهورية تحولت المكاتب السياسية وهيئات الضباط الحاكمة إلى قبائل تغرف من الثروات العامة كذلك.
هنا نجد تعبيرات جديدة مثل الميزانية العامة، التي فرضها الاستعمار بسبب الضرورات الاقتصادية المختلفة، ولكن حتى الإقطاع السياسي الديني في العصر العباسي والفاطمي الخ.. كان يخصص أموالاً للخدمات العامة، أي ليس ثمة هنا تغيير جوهري، فلاتزال الميزانية في يد الحكام، وهم لا يكتفون بذلك بل يطمعون حتى في الميزانية العامة التي خصصت للإنفاق العام، عبر دخولهم إلى الوظائف العامة، وتخصيص نسب ومكافآت لهم، إضافة إلى العمليات غير القانونية الكثيرة التاريخية، كعدم تحديد الأراضي العامة والمشاعية وكيفية التصرف بها الخ.. والعمليات غير القانونية العادية كإرساء المناقصات عليهم، وبيع الممتلكات العامة بمبالغ رمزية لهم وتحديد النسب الكبرى من الوظائف لهم ولأسرهم ومعارفهم وأقربائهم الخ..
لم يعد الحاكم يقول للغيوم بأن خراجها هو له أين ولت بوجهها، لكن المضمون هو نفسه، لكن الخراج لم يعد فقط في الزراعة باعتبارها القطاع الرئيسي الوحيد في أسلوب الإنتاج، بل أضيفت إليها الصناعات الاستخراجية، «البترول، والفوسفات الخ…» وهي شكلٌ آخر متطور عن الزراعة، فهي لا تقوم بتحويل تقني واسع لقوى الإنتاج، بل تعتمد على شطف المادة الأولية واستخراجها وتصفيتها الأولى. كما أن الزراعة ذاتها دخلت في عمليات تصنيعية محدودة، غير أن ذلك لا يغير في علاقات الإنتاج.
إن ذلك يؤدى إلى احتدام التناقضات بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج؛ في ظل أسلوب إنتاج واحد، حيث أخذ يتعرض لصراع متفاقم متعدد المصادر . ولكن أين تكمن عقدة «علاقات الإنتاج»؟ إنها تكمن في السلطة وأسلوب إدارتها للثروة العامة.
إن أساليب الإنتاج الغربية المماثلة لأساليب الإنتاج الشرقية تختلفُ في كون العقدة موجودة خارج السلطة، لكن أساليب الإنتاج الشرقية، ووريثتها الراهنة علاقات الإنتاج الإقطاعية – المذهبية، تكمن عقدتها في السلطة بجانبيها السياسي والديني.
ولهذا فإن الباحثين عن موديل مماثل في تاريخ الغرب، لكي يطبقوه وينقلوه إلى العرب والمسلمين، لن يجدوه.
ولهذا فإن علاقات الإنتاج تتكون من خلال السلطات الشرقية عبر تاريخ الهوة العسكرية وتشكيلها للمجتمعات. ومن هنا فإن العصر الحديث افتتح بالقوى الغربية العسكرية ومحافظتها على أسلوب الإنتاج السابق – الراهن، فلا أحد يستطيع أن يغير أسلوب الإنتاج بقرارات.
إذا كانت الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج الرئيسية الإقطاب المذهبية في المنطقة تغدو بالضرورة هي الطبقة الحاكمة سياسياً، فإنها لا تتشكل من خلال انبثاقها من عوى الإنتاج، بل من خلال القوة العسكرية التي عبرها تفرض ُ سيطرتها على قوى الأنتاج، سواء كان ذلك من خلال الأسر القبلية أو زعماء الطوائف كما في لبنان؛ أو من خلال الضباط الأحرار واللجان المركزية للأحزاب الخ ..
ويغدو الحكم ناجحاً أو فاشلاً بشكل اقتصادي مؤقت عبر نجاح القوة العسكرية في فهم الإنتاج وتطويره. ولهذا فإن عمليات الإصلاح الاستعمارية التي تمت في بداية القرن العشرين الميلادي كنست الجوانب الأشد تخلفاً فى أسلوب الإنتاج الإقطاعي الموروث، كالرقيق والغياب الكلي للمرأة عن سوق العمل، ونظام السخرة، ونظام أهل الذمة، ولا مركزية الدول الخ..، وهي خصائص عموماً غير جوهرية وغير أساسية في أسلوب الإنتاج الإقطاعي. ولهذا فإن جانباً كبيراً من الثروة العامة ظل في يد قوى الإقطاع السياسي، فدخول الاستعمار الغربي لم يكن ثورةً برجوازية بل كان مخافظةً على الإقطاع في ظل إصلاحات محدودة.
ان تشكل الإقطاع السياسي الجديد بدءاً مما يسمى بـ«الثورة العربية الكبرى» حافظ على ملكية الحكام وأتباعهم للأراضي الكبرى في المشرق العربي الشمالي، حيث كانت لاتزال الشكل العيني الهام للثروة، وفي مصر كانت أسرة محمد علي العسكري الألباني هي التي حددت الملكية الكبيرة ووزعتها، وقامت الإدارات الاستعمارية في شمال افريقيا بتحديد من يملك أكبر حصة من الأرض وفي ثورة المهدي في السودان رفض المهديون توزيع الأراضي على الفقراء مما أدى إلى انتصار الإنجليز، وقام الوهابيون بتملك الثروة العامة في الجزيرة العربية عن طريق الحروب ونظام الغنائم الخ..
إن ملكية الأرض الكبرى في زمن التحول من العصر الوسيط إلى العصر الحديث في العالم العربي، كانت هي الشكل الاقتصادي الهام في عصر الانتقال الأولي من الإقطاع إلى العصر الحديث العربي، والتي أنتجت الريع العقاري وأشكاله، كشكل مباشر للإقطاع الاقتصادي، وهو المستوى الوحيد الذي يفهمه الباحثون التقليديون للإقطاع. نظراً لخلفيتهم الأوروبية الدراسية وعملية النقل الجاهز منها.
لكن ملكية الأرض لم تعد هي الثروة الكبرى مع تطور الاقتصاد وعمليات التفاعل بين الاقتصاديات المحلية والغربية والعالمية عموماً، بل إن الزراعة راحت تتدهور، وأخذت أسعار الغلات الزراعية فى هبوط مستمر، ثم غدت الأرضُ كعقار هي مصدرُ الدخل الأهم؛ ولهذا فإن عائلات الإقطاع السياسي هي التي استفادت من تخصص الأراضى الزراعية ذات المحصول الغني كالقطن في مصر والسودان أو التمور فى العراق أو اللؤلؤ في الخليج أو الحرير في لبنان الخ.. وقد تحدث عمليات التداخل بين الأراضي الزراعية والسيطرة السياسية المؤدية للضرائب والمكوس وغير ذلك.
لكن الثروة العائدة من المواد الخام التقليدية الزراعية أخذت تتراجع، ومع ظهور النفط في العراق بعد الحرب العالمية الأولى أخذت المواد الخام الصناعية المكانة الأولى في تشكيل الإقطاع وثروته. وكما كانت مفاتيح الأرض الزراعية والأرض المشاعية تنتقل لشيوخ القبائل والحكام والموظفين الكبار فإن صفقات الاستخراج الجديدة والتصنيع المعالج الأولي كانت من نصيب من هم في الحكم، أو أن الامتيازات تتضمن حقوقاً اقتصادية تعود للهيمنة السياسية. وبذا فإن كبار المهيمنين على الحكم والأرض انتقلت سيطرتهم إلى الصناعات التحويلية والنشاطات الاقتصادية الحديثة. إن انبثاق الثروة من السلطة السياسية والقوة ينتقل من الأرض إلى البنوك والصناعة والاستخراج وفيما بعد إلى المحافظ النقدية الغربية والعمليات المالية الدولية. لكن هذا لا يغير من الطابع العام للتشكيلة الإقطاعية ــ المذهبية.
إن العلاقات الرأسمالية المتنامية في النظام الإقطاعي العربي والإسلامي تُؤسس من قبل قوى السلطات، ولهذا فإنها تُوضع بعيداً عن البناء الاجتماعي، فالألوية السياسية المسيطرة لا تقوم بخرق الأبويات الأسرية والقبلية والهيمنة الذكورية والثقافة الطائفية المسيطرة، فهذه كلها تبقى خارج علاقات الرأسمالية المتولدة من الحكم الإقطاعي المسيطر. إن العلاقات الرأسمالية تشتغل خارج مملكة النفوذ الاقطاعية الراسخة، لكنها تملأ خزائنها بالفيض النقدي، الذي يؤدي للمزيد من الرسوخ للعلاقات المحافظة.
لكل بلد عربي وإسلامي مستوى معين من التطور ومن شكل التجلي الخاص به لسيرورة الإقطاع – المذهبي. إن الرأسمالية الطالعة من تحت عباءة الإقطاع تنبثق من العمليات الاقتصادية الكبرى لهذا الأخير، ففي مصر يظهر الرأسماليون من الريف ومن بيع القطن وتصنيعه، ثم يكبرون، في حان يظهر الرأسماليون في العراق من العمليات الزراعية ومن النفط، وفي الجزيرة العربية من التجارة البحرية والغوص على اللؤلؤ ومن ثم النفط، وفي لبنان من الزراعة ثم التجارة الواسعة الخ..
إن ارتباط ظهور رأس المال بالسلطة كعامل أساسي لأنتاج الفيض النقدي، تتشكل على أثره الطبقات والفئات على قدر اقترابها من نبع المال، وبالتالي فإن طابع الحكم العشائري أو القبلي أو الطائفي أو العسكري يحدد كم التوزيع، وكلما تبعثر الفائض الاقتصادي على كم سلطوي كبير ينفقه في استهلاكه، ازداد الخلل في البناء الاجتماعي.
وتتضاعف الأخطار حين يكون التركيز شديداً في القمة، أو مرتبطاً بقرارات مغامرة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
إن ملاك الأرض المصريين حين نقلوا الفيض النقدي الزراعي إلى الصناعة والبنوك والحرف في الثلاثينيات تجنبوا الأزمة ووسعوا من التطورين الاقتصادي والثقافي. والرأسمالية المصرية تعاني الأن عدم قدرتها على رسملة الريف مصدر ثروتها الأول ودون ذلك يصعب انتقالها إلى الرأسمالية «الحرة».
إن ظهور الثروات الراسمالية داخل التكوينات والعائلات والشرائح الإقطاعية، يجعل نمو الرأسمالية مرتبطاً بالأجهزة السياسية الحاكمة أو المعارضة التي تنتقل للسلطة، لتكرس السلطة الإقطاعية المذهبية كيفية نمو التجارة والصناعة والبنوك، فتقوم العائلات المتنقذة بالسيطرة على الموارد العامة، وكلما اقتربت من هرم السلطة ازدادت ثروتها ونفوذها وتوسعت أعمالها الاقتصادية. وكلما تنامت ثرواتها تغلغلت في السلطة أكثر.
ولهذا فإنها تقوي أساسها الاجتماعي الإقطاعي – المذهبي، على أساس ركائزها المذهبية والاجتماعية، فإذا كانت طائفة مارونية أو سلطة سنية فستحافظ على مذهبيتها كمصدر أولي للثروة وللسلطة وللحشد الاجتماعي وسوف تكرس تمايزها عن الطوائف الأخرى، أو إذا كانت إدارة دولة متوارثة بيروقراطية شمولية فستحافظ على تمايزها كجماعة «مسلمة» في مواجهة مسيحيين، أو في مواجهة بربر، أو أكراد أو زنوج الخ..
تغدو السلطة السياسية، أو السلطة المذهبية، مصدرين لتوزيع الثروة وتناميها وهي القادمة من المنتجين، أو لدمارها كذلك، ولتداخلها ولصراعها، فلكونهما موزعتي الثروة يجري الصراع الشديد حولهما، وبينهما.
إن كون السلطة والمذهب مصدري توزيع الثروة على القوى الاجتماعية المختلفة، يجعلهما مستقرين ومتوحدين في أزمنة النهضة، ولكنهما يتزعزعان في أزمنة الأزمة، فتنشأ مراكز متعددة للسلطة، وتظهر المذاهب المتصارعة، وقد عرفت أزمات الإقطاع المذهبي لدينا عدة حلول أساسية، فأما تفكك النظام السياسي، وإما سيطرة سياسية جديدة تعيد توزيع الفائض الاقتصادي بطريقة جديدة، وإما الحرب الأهلية التي تعيد المتصارعين إلى ما قبل الانفجار.
وخيار الدول العربية الآن هو سياسات جديدة تبعد مصدري الثروة الدولة والدين عن أن يكونا موزعي الثروة، وتعود آليات توزيع الثروة للأنظمة الاقتصادية المحضة، وقوى الإنتاج المختلفة.
زايد بن سلطان آل نهيان
زايد بن سلطان آل نهيان 1918 ــ 2004
المواطنُ لا يُذل
حين أبصرَ الشيخُ محمد بن زايد آل نهيان إن ثمة فتحة في إحدى الوزارات الحكومية بدولة الإمارات العربية تــُجبرُ المواطنين وهم يستلمون الأوراقَ على الأنحناء وعلى إدخال رؤوسِهم تحت حديدها، جاءَ وطلبَ تكسير هذه الفتحة المُذلة وجعلَ رؤوسَ المواطنين عالية شامخة لا تنحني!
وليس هذا بغريب على أبناء زايد، فهم قد ورثوا الحكمة والتواضع من أبٍ كبير، أعطى أمثولة في الحكم، وصار شجرة خضراء كبرى تـُعطي بذورها وثمارها لمن يسمو بنفسه ويرتفع لمهام التاريخ العظيمة!
لم يكن زايد آل نهيان في بدء حياته الحافلة بالعطاء سوى شاب عانى الكثير، وعرك حياة الفقراء البسطاء، وحين جاءهُ الحكمُ وجاءتهُ الثروة الخرافية لم ينفصل عن ذلك التاريخ، ولم يقطعْ علاقته بالمحرومين، ولم يتكبر أو يتجبر، بل طور هذه العلاقة لتغدو نظرة كبرى ومدرسة لمن يريد أن يتعلم، وما أقل المتعلمين وأكثر الحمقى المغرورين!
كانت الدولة صحراءَ شاسعة، لا حدود لرملِها وجفافِها، فأخضرت وتحولت رمالها وصخورها وجدبها إلى أكبر حديقة في الجزيرة العربية، والدولة التي كانت بلا نخل صارت النخيل غابات فيها، وزادت عن ثلاثين مليون نخلة!
وزايد الذي عاش في الشظف والصحراء، فأثرت ثقافته ونظرته السياسية، كان هذان العدوان أكبر خصمين له، فراح يجثتهما زراعة خصبة لا تعرف الاستسلام أمام العدو الأصفر، وإغنى المواطنين بحيث أن الفقر غدا لعنة من الماضي!
والمواطنون الذين كانوا يعيشون في الخيام أو البيوت الحجرية الصغيرة، صارت بيوتهم أكبر من مضمار الخيل، يعيشون ويزرعون ويتريضون ويضعون سياراتهم في كل هذه المساحة.
وهذا البدوي المفكر، والشعبي المثقف، كان يعبر بلغته عن أفكار معقدة لدى المثقفين والحداثيين، فعبر عنها بمنطقه ولغته البدوية، لكنهم لم يفهموها وغابت عن أنظارهم لأنهم يريدون اللغة المتحذلقة، وبيانات يعدونها من ورائه أناسٌ مزورون منافقون، يضعون على لسانه كلمات من منتدياتهم ومن جعجعتهم الفارغة ويحشونها بعبارات وألفاظ منتفخة لا مضمون حقيقي لها وهي زائفة مثل الحديد المطلي بقشرةِ فضةٍ رخيصة، ولكنه كان يريد أن يعبر عن نفسه بنفسه، وبألفاظه التي تبدو لهم مضحكة، لأنهم وكلماتهم زائفون، ولكن لغته البسيطة تتطابق مع أعماله العظيمة!
ومن هنا لم يحتاج لفرق الطبالين والمشعوذين وحملة البخور الذين يفبركون المقابلات واللقاءات ويكتبون ما شاءت لهم الكتابة، المدفوعة الأجر، فزايد لم يحتاج إلى مثل هذه الصناعة الإعلامية الكاذبة، لأن أعماله تشهد له، ومن لم ينظر لضخامة هذه الأعمال، ومن لم ير مثل هذه المنجزات فلا فائدة من كلامه ومن بيانه!
كان المختلفون معه هم الذين يشيدون به، وكانت إنجازاته تتحدث بنفسها، فلا حاجة لتطبيل وتزمير في الصحافة والإذاعة والتفزيون وفي الحزب المسيطر ومن جلبٍ للصحفيين الذين تـُشترى الدستة منهم بدينار، فيكفي هذه الخيرات التي تنصب على الشعب وعلى البلدان العربية والأراضي المحتلة وجنوب لبنان وعلى البلدان الفقيرة، لتتحدث عن نفسها، وكفى بالخير شاهداً ولساناً ناطقاً!
وهذا الرجل البسيط كان أبعد نظراً من السياسيين، فقد تمرد في بدء تكون دولة الإمارات نفرٌ من الشباب الغض، وأراد الحرب، فاستدعاهم زايد واقترح عليهم أن يعبروا عن آرائهم ويثقفوا الناس عبر جريدة أو مجلة، لعل هذه الآراء تنتجُ شيئاً طيباً، بدلاً من المراهقة، لكنهم لم يستفيدوا فضاعوا، فكيف لحاكم أن يشكلَ معارضة ويدعوها للبقاء لا للزوال؟!
وأخضرتْ كلماتُ زايد كما أخضرتْ الأغصانُ الصغيرة التي زرعها في الرمال، وغطت الأشجار والنخيل التي زرعها الشمس الحارقة، وأتت المنجزات أُكلها في دولةٍ كبيرة، متقدمة، مليئة بالحريات، نادرة المشاكل، ذات شعب مرفوع الرأس، سعيد. وتأثر الحكامُ الحكماء منه وتعلموا وغيروا من حياة شعوبهم.
وأخضرتْ كلماتُ زايد كما أخضرتْ الأغصانُ الصغيرة التي زرعها في الرمال، وغطت الأشجار والنخيل التي زرعها الشمس الحارقة، وأتت المنجزات أُكلها في دولةٍ كبيرة، متقدمة، مليئة بالحريات، نادرة المشاكل، ذات شعب مرفوع الرأس، سعيد. وتأثر الحكامُ الحكماء منه وتعلموا وغيروا من حياة شعوبهم.
فتحية لزايد وأبنائه وسيرته العطرة لتبقى نموذجاً في الحكم.
الشيخ زايد والآخرون
من أصابع الشيخ زايد تدفقت أنهار الزيت والماء والحدائق والظلال في الصحراء العطشى.
إن هذا الرجل الصحراوي القادم من (العين) في مستهل الثلاثينيات، اكتنز بحكمة العرب في خيامهم وبراريهم وبعد نظرهم، أعطته البساطة سعة الصدر، والقصص والشعر والأمثال معاني إنسانية جديدة للسياسة الدولية المثقلة بالحديد والنار.
جاء والبخلُ مهيمنٌ على الحكام، والجدبُ والصحراءُ في الأرض والحكم، وكان بعض المتنفذين يريد نقل التجارب العربية الانقلابية والدموية والمتعالية على الشعوب إلى الجزيرة العربية موطن البساطة والألفة.
كان النفط يتدفقُ ومعه الثراء والانفصال عن الناس وعن القيم، فصار البعض أباطرة وحولوا خيامهم وأبلهم وقطعانهم إلى قصور فارهة وقلاع مفصولة عن الناس، مليئة بالتايلنديين والبنغال، وصارت بلدانهم مجرد حصالات يجمعون فيها الزيت والنقود والعظام ويضعونها في حصالات غربية وشرقية أوسع.
جاء زايد لينشر الخضرة والغابات في الصحراء العربية التي لم تر السدود والأنهار منذ سد مأرب، ومنذ أن سرقت الفئران ذهب النساء، وحولت أهل الجزيرة إلى قوافل للفقر والتسول في الدول الأخرى.
كان أهل الحكم لا يتحملون الرأي الآخر، وقد تمرد بعض المثقفين الإماراتيين على الدولة، وكانوا يريدون نقل دبابات البعث والحرس القومى وبيانات أحمد سعيد إلى البدو البسطاء، فاجتمع معهم زايد وقال انشروا يا أولادي أفكاركم بين الناس، وأنا أعطيكم صحيفة تبثون منها آرائكم، فإذا كانت جيدة فسوف تنبتُ في الأرض، وإذا كانت سيئة فستذهب مع سيول المطر والعشب. لكن المثقفين الانقلابيين رفضوا حكمة الفيلسوف البدوي، وأصروا على الانعزال والرفض، فكرت السنون وتبخروا في الهواء !
كان المثقفون الانقلابيون يتطلعون الى أمثال (ناقص)، إلى ذلك الثوري المزعوم المتشدق، واللص في الحقيقة، الذي جاء للحكم وبلاده واحة خضراء، مليئة بآبار النفط والأنهار والحدائق المعلقة، وإلى أمثال هذا من المترفعين والمغرورين الذين جلسوا على الكراسي فزادتهم غروراً وطغياناً، هؤلاء المتشدقون بخدمة الأمة والشعب، الذين لا يسيرون إلا وحولهم الحشود من العسكر والمسدسات معلقة في خصورهم، خائفين مرعوبين من أي عصفور يمر وأي فراشة تحلق!
وكانوا يمطرون الناس كل اليوم بالخطب العصماء عن الإنجازات، وتوحيد الأمة، ورفع الشعب إلى الذرى، وهم لا يبقون على مدخرات رياض الأطفال وبراءة الشواطئ ويأكلون الأخضر والجبال والجزر والواحات والصحاري.
وكان زايد يعمر الصحراء، وينشر الحدائق والبيوت العامرة والسدود والمدن في العالم العربي والإسلامي، فيعرفه البدوي المنعزل في الصحراء المغربية، وينزعج ثقبُ الأوزون من أصابعه الخضراء.
في حين كان (ناقص) يقود شعبه إلى الحرب الأهلية وإلى استخدام القنابل الكيماوية في مأثرة كبيرة للحكام العرب المهتمين بالتنمية الجماعية للإبادة، وتحويل البدو ذوي الكرامة وعزة النفس إلى جلادين، ومخبرين، ثم إلى حرق بيوت هؤلاء البدو والفلاحين وتجفيف العيون والأنهار ونشر المستنقعات وتحويل البلد إلى خرابة كبيرة وحصالة هائلة لجمع أموال الزيت ونشرها على الأقرباء والمنتفعين والفاسدين ..
تحولت أبوظبى إلى حديقة كبرى، وجاء الناس من كل أنحاء الدنيا للعمل وامتدت أنابيبها وشرايين الحياة إلى المعوزين، وأخذت النخيل تغطي السماء، في حين كان ناقص يزيل الحدائق ويحول البلد إلى بلد العاهات والفقر والتصحر!
November 30, 2023
رموز في مرحلة جديدة ــ كتب : عبدالله خليفة
ليس أسهل من الانسحاب من المعركه، فأن يقوم شخص قيادي بالعودة إلى الصمت والعزلة، فهو أمر سهل.
وليس أصعب من أن تغير الرموز أدوات نضالها في زمن مختلف، يحتاج إلى عدة جديدة، وعادات جديدة، وتطوير الناس في سكك مختلفة.
التغيير في مرحلة الإصلاح أسهل من التغيير في السابق، لأن لديك جهات رسمية واسعة تدعمك، وما عليك سوى أن تجمع الرسمي بالشعبي، البرلماني بالنقابي والتجاري الرأسمالي والصناعي بالعامى..
أي أن تتعلم لغة سياسية جديدة، وأن تحاور من لم تحاوره أبداً، وأن تستبدل عداواتك القديمة، بصداقات جديدة.
إن الواقفين على السكك العتيقة، والذي يريدون مواجهات صاخبة، أو الذين يريدون عرقلة الإصلاح المتسارع، سوف لن يجدوا في أيديهم سوى قبض الريح، لأن عجلة التاريخ أقوى من أن نقاومها، فقد قاومها الشاه ولم يبق، وقاومها صدام بأعتى القوى، فشرد جماعته وقتل أهله، وغداً لناظره قريب.
غداً ستأتيك الأخبار المذهلة، بحيث سيذهلنا التاريخ أكثر مما أذهلنا.
إن خريطة المنطقه كلها معروضة للزلازل، فتمسك بالعروة الوثقى، وبالإصلاح، وبخدمة الناس، وبالنزاهة، فلن يبقى فاسد عاتٍ، وسوف تعرض كل الحسابات للجرد.
ولدينا أجهزة سارعت إلى الأصلاح، فلماذا لا تعرف رموزنا المناضلة لغة الصبر وبُعد النظر، وتكوين اللغة العقلانية بين كل أطيافها وألوانها ولهجاتها، من أجل أن تكون هذه صفحه جديدة في تاريخ الوطن؟
لكن الإصلاح والتغيير والتقدم لا يأتي من الهواء بل من نشاط الطلائع وذكائها وعلاقاتها الوثيقة بالناس، وكيف تستطيع أن تقدم المشروعات وتدعم الإيجابي حتى لوقدمه منافسي السياسي، وتعارض السلبى حتى لوقدمه صديقى.
لو أن كل عضو في جمعية سياسية التفت إلى واجبة السياسي، الإصلاحي، ودعم المفيد والبناء في المجتمع، بغض النظر عن صاحبة والمستفيد منه، لو أن معارض الوزير في الشارع رأى أفعاله الإيجابية فعليه أن يسارع بتأييده، ويدع الخصومة السياسية جانباً.
لا نريد الصراعات الشخصية والعداوات الصغيرة، نريد جبهة واسعة للإصلاح تضم القوى الرسمية والشعبية، نريد التركيز على ما يفيد الناس، وسوف تصغر حينئذٍ دائرة الفساد والعداوة للإصلاح.
سيجد الكثيرون أنفسهم بحاجة إلى أن يعرضوا كشوف حساباتهم في الوزارات والشركات، سيجد الكثيرون ان الربح القانوني أفضل بكثير من كسب عداوة القانون والمجتمع والجمعيات السياسية والنقابات.
لماذا لا تحاول الرموز إذن تجاوز جمعياتها الصغيرة أو الكبيرة المغلقة بأن تكون رموزاً لجمعيات أخرى؟
لماذا الانحصار في الدوائر الضيقة وعدم توسيع المدار، ولا يتداخل الوطني بالتقدمي، والإسلامي بالعلماني، تداخل الكشف والحوار والمعرفه، لا تداخل الالتفاف؟
إن كسر الدوائر الإيديولوجية المغلقة والبحث عن المشترك الديمقراطي، يمكن أن يكون في اللقاءات ولكن في المجلات المشتركة، في الصحف المشتركة، في المواقع الموحدة والمتعاونة، في الندوات، في مؤتمرات البحث في التاريخ الوطني والقومي، في التعاون النقابي الخ . .
لا يستطيع أن يقوم بذلك سوى رموز في مرحلة جديدة، تتوجه لتغيير الماضي، المحدود، وتكسر الجليد الطائفي، والسياسي المترتب عليه، وتنداح في موجات وطنية تعيد صهر الوطن في مرحلة مختلفة.
وأن يبداً ذلك في منظمات الشباب أيضاً، بدلاً من أن يكرس الشباب عداوات لا يعرفون عنها شيئاً ولا تخصهم.
هل تزول مرحلة القبائل السياسية القديمة والجديدة، وتعد التيارات نفسها لتغيرات اكبر تتطلب أدوات فكريه وسياسية مختلفة ؟
الإقطاع المذهبي والريع
إن كونَ السلطة — المذهب مصدرُ توزيع الثروة على القوى الاجتماعية المختلفة، يجعلها مستقرةٍ و متوحدةٍ في أزمنة الرخاء ، ولكنها تتزعزع في أزمنة الأزمة، فتعجز السلطةُ السياسيةُ المذهبية عن التحكم في البنية الاجتماعية، نظراً لهذا التركز في السيطرة على المال العام وإهداره بأشكالٍ مختلفة، فيغدو المذهبُ مركزاً لسلطةٍ مضادة، أي أن الجماعةَ السياسيةَ المسيطرة على النظام المذهبي، تُنافسُ من قبل الجماعةِ السياسية المسيطرة على إنتاجِ المذهب، فيظهر الصراعُ وكأنه صراع بين السياسيين الحاكمين التحديثيين والدينيين، ولكنه صراعٌ بين أجنحة الإقطاع المختلفة، بل بين جناحيها الرئيسيين، بين الجناحِ السياسي الحاكم المسيطر على جهاز الدولة والثروة التي يصنعها، وبين الجناح المسيطر على إنتاج المذهب والثروة التي يصنعها، وإذا حدثت سيطرةٌ للجناح المذهبي السياسي، فإنه يعيدُ إنتاجَ نظام الأقطاع المذهبي بسيرورة أخرى.
أما لماذا أمكن حدوث هذا النوع من الصراع؟ فهو يعود لتنامي إعادة نظام الإقطاع المذهبي خلال القرن العشرين، وعجز الدارسين عن معرفة هذا الوضع هو بسبب عجز أدواتهم التحليلية وعدم متابعة التطور للمنطقة خلال القرون السابقة.
والجهل بهذه القضية الهيكلية في الحياة السياسية والاقتصادية يصل حتى إلى المتخصصين في شؤون تفسير الحياة السياسية والاجتماعية، مثل هذه العبارات التالية:
(ومهما كان الحالُ، فإن طبقةٍ صغيرةٍ كانت، ولا تزال تسيطرُ على ثروات البلاد بالتحالفِ مع الشرائح والفئات الحاكمة حتى ليصعب الفصل بينها، فتكادُ أن تشكل طبقةٍ أو عائلةٍ واحدة. ما يمكنُ قولهُ بدقة إن البرجوازية القديمة، وهي التي تشكلتْ من كبار مالكي الأرض والرأسماليين في التجارة والصناعة والمال، تمكنت تاريخياً من السيطرة على الحكم والثروة معاً)، (المجتمع العربي في القرن العشرين، الدكتور حليم بركات، مركز دراسات الوحدة العربية، ط ١، ص٣١٩).
هذا تحليلٌ يكاد يضعُ غموضاً على الظاهرة أكثر مما يحللها، فكيف تكون هناك طبقة مسيطرة ولكنها تتحالف مع الشرائح الحاكمة؟ وتكون هناك برجوازية قديمة وهي من كبار ملاك الأرض؟!
إن أي قوةٍ سياسيةٍ تسيطرُ على جهاز الدولة التقليدي المذهبي تحوله إلى أداةٍ لصناعة الثروة، فتصبح قوةٍ إقطاعيةٍ سياسية مهيمنة، سواءٍ أكان ذلك بلباس الباشوات أم بلباس ضباط الانقلابات، أم بفتوات الجماعات الدينية، فاستخدام السيوف أو استخدام الدبابات، للسيطرة على الدولة يحلقُ الإقطاعَ السياسي، واستخدام القوة للسيطرة على المذهب يخلقُ الإقطاع المذهبي، وهما قد يتآلفان في زمن هو زمن سيطرة جناح فيهما، وقد يتصارعان حين يجد الإقطاع المذهبي نفسَهُ في قوةٍ قادرةٍ على الوثوب للسلطة .
ولكن القوتين معاً تشكلان نظاماً واحداً هو نظام الإقطاع المذهبي، ويخضع توزيعُ الطبقاتِ والفئات لهذا النظام في زمنية بنيوية خاصة من تطور أسلوب الإنتاج، أي لا بد من قراءةِ كل بنيةٍ محددةٍ في زمنيتها، وهذه تحددُ مستوياتِ البنيةِ الداخلية وتأثيراتها المناطقية في المنظومة الإقطاعية المذهبية (الإسلامية) وفي العالم.
(ويقولُ خلدون النقيب إن عصرَ النفط بدأ في الجزيرةِ العربيةِ في الثلاثينيات وخلال عقدين بعد ذلك بدأت تتوضحُ معالمُ الدولة الريعية نتيجة الزيادة الكبيرة في الدخل بشكلِ ضرائبَ ريعيةٍ تحصلُ عليها الأسرُ الحاكمةُ من شركات النفط، وهو ريع خارجي غير مكتسب ولم يتولد من العمليات الإنتاجية للاقتصاد الوطني. ويتبعُ ذلك منطقياً أن الدولة التي تعيشُ أو تعتمدُ في معاشها على الريع الخارجي هي دولة ريعية، ونتجَ من ذلك أن أسهمت التعويضاتُ العامة في خلق اوليغارشية مالية عقارية طائلة الثراء، وفي تحويل قطاع الاستيراد والتصدير إلى أكثر قطاعات الاقتصاد دينامية وكان المستفيد الأعظم منها أفراد الأسر الحاكمة والعائلات التجارية الكبيرة التي تملك مساحات واسعة من الأراضي العقارية (المصدر السابق، ص ٣٢٠ – ٣٢١).
تبدو المُلكية الريعية في رؤية بعض الدارسين ومنهم خلدون النقيب وحليم بركات الذي استشهد بالأول في كتابه (المجتمع العربي في القرن العشرين)، وهو كتاب ضخم في أكثر من ألف صفحة! وكأنها في فراغٍ اجتماعي وتاريخي، ولكن ليست دخولُ النفط ريعاً، ولكنها دخول ناتجةٌ عن الحكم السياسي.
والريع هو دخل ناتج من ملكية الأرض ولهذا فهو إيجار عن ملكية، وأحياناً يتم التوسع في الريع ليصير أي دخل نتاج ملكية عقارية.
ولكن حكومات النفط لا تستأجر النفط، فهي حكومات سياسية، لا تملك النفط قانوناً، بل يملكه الشعب في أي دولة معنية، وأي دخل هو دخل سياسي، وليس دخلاً اقتصادياً، بمعنى إنه نتاج وضع احتكاري للسلطة.
وثمة فرقٌ بين الإقطاع السياسي وبين الإقطاع الاقتصادي، فالإقطاع الاقتصادي هو كملكية الأراضي الزراعية التي ينتجُ عنها إيجار يدفع لصاحب الأرض، ويطلق عليه محلياً الضمان، وهو يجسد الإقطاع الاقتصادي أفضل تمثيل.
أما الإقطاع السياسي وتملك فوائض النفط بصورة حكومية من قبل بعض الجماعات والأسر والحكومات، فهذا كله يتشكل في زمن الاستعمار باتفاق بين الدول الأجنبية المسيطرة والجماعة الحاكمة محلياً، أو بينها وبين المتنقدين أياً كانت ألوانهم، ثم تقومُ الجماعةُ الحاكمةُ المحلية بوضع يدها على هذا المال في زمن الاستقلال، وعبر هذه السيطرة الإقطاعية على جهاز الدولة تنمو المداخيل وتتشكل الطبقاتُ تبعاً لقربها وبعدها عن هذا المال المسيطر عليه، ولهذا تغدو هذه الطبقات والفئات تابعة ومنتجة من قبل الإقطاع السياسي الحاكم.
ولهذا فإن تعبيرات فئات ريعية وقوى ريعية تقود إلى إخفاء الطابع السياسي والاجتماعي لمسألة الإقطاع، وكأن الحكومات التي تؤجر النفط وتستغله دخلاً هي مثل القبائل التي تبيع مياه الآبار على القوافل، وليس أنها مسئولة سياسية عن ملكية عامة لا تعود إليها، وكل تصرف غير قانوني له نتائجه التاريخية. (وكل ما بني على باطل فهو باطل شرعاً وقانوناً).
ولكن تعبير (الريع) ينساق مع النظام الإقطاعي، فكأن بريطانيا تملك فلسطين عندما حولت ملكيتها إلى الجماعات الصهيونية. أو أن ملكيات الأسر للمال العام والثروات الاقتصادية كالمناجم هي ملكية شخصية وليست ملكية عامة لا تعود إليها.
وإضافة على الغموض في هذا التعبير فإنه خادع سياسياً ونضالياً، فمصطلح الريع يجعل مسألة النظام الاجتماعي غامضة، وإذا غابت مسألة النظام الاجتماعي التقليدي و إنه نظام ما قبل رأسمالي فقدنا البوصلة التاريخية في إنتاج نظام بديل وحديث، سواء من قبل السلطات التي تشكل هذا النظام التقليدي أو من قبل قوى المعارضة التي ترتهن بهذه المظلة الاجتماعية – السياسية.
ومن هنا نرى كيف تتحرك تيارات الإقطاع المذهبي في الحقبةِ النفطية، نظراً لظهورِ هذه الدخول الكبيرة فى المناطق الصحراوية ذات المستوى غير المدني، لهذا تغدو الثقافة الإقطاعية المذهبيةُ متفشيةٍ، وهذا لا يعني أن الثقافةَ العربيةَ المدنية السابقة خلت من حضور الإقطاع المذهبي، لكنها كانت متواريةٍ بمساحيق (قومية ووطنية) نظراً لذلك المستوى المدني لكن مع صعودِ المناطق الرعوية والزراعية تم ضخ هذه الثقافة المذهبية السياسية بتنويعاتها في الأقسام العربية الأخرى.
وحسب مذهبية الأسر والجماعات الحاكمة يتم ضخ المادة الدينية، فتعودُ الصراعات المذهبية القديمة، لكن فوق ثروات وعلاقات دولية مختلفة.
ومن هنا نستطيع أن نعرف تنويعات الإقطاع المذهبي في منطقتنا: السني، الشيعي، المسيحي، البربري، المهدي السوداني، الدرزي، الإسماعيلى، الكردي الخ.
ولا تبدل المنطقة إلا معرفة تاريخية واستراتيجية بهذه القضية وعبر إنتاج ثقافة ديمقراطية توحيدية لجمهور المسلمين ومن يشاركهم فى هذه الرقعة الواسعة.
أما كلمات مثل الريع فهي خاطئة اقتصادياً وتغييبية فكرياً. .



