ابن باجة* : كتب ــ عبدالله خليفة
1 ــ معنى التوحد
في كتابه (تدبير المتوحد ) يتوجهُ ابن باجة إلى تعبيرٍ جديدٍ في الفلسفة العربية الإسلامية هو (التدبير) ، ويُقصد به ( ترتيب الأفعال نحو غايةٍ مقصودةٍ ) ، (1 ) وهذا التدبيرُ يتصفُ بالكثرةِ ويُؤخذُ من حيث هو ترتيب ، ويتصفُ بارتباطهِ بالأعمال الكبرى في الحياة ولهذا ( يُقال في ترتيب الأمور الحربية ) ، ( وأشرف الأمور التي يُقال عليها التدبير هو تدبير المدن وتدبير المنزل ) ، (2 ) .
ويتداخلُ تصنيفُ ابن باجة هنا في التدبير مع فلسفتي أفلاطون والفارابي اللذين يذكرهما في الفصل الأول مراراً ، والفلسفتان هما المتعلقتان بالجمهورية أو بالمدن الفاضلة ، ولهذا تأتي ألفاظٌ في هذا الفصل مثل (الصناعة المدنية) و(المدينة الفاضلة) ص 8 ، فتتداخلُ كلمةُ (المنزل) مع المدينة على نحوٍ غامضٍ في تعبيراته التي تمتاز بالتداخل وعدم الوضوح :
(فإن وجوده الأفضل أن يكون مشتركاً ، وكيف صفة اشتراكه ؟ وأما المنزل في غير المدينة الفاضلة ، وهو المدن الأربع التي عدت ، فإن المنزلَ فيها وجوده ناقص وأن فيه أمراً خارجاً عن الطبع ، وأن ذلك المنزل فقط هو الكامل الذي لا يمكن فيه زيادة فلا تعدو ناقصاً ، كالأصبع السادسة ) ، (3) .
من الواضح هنا بأن المنزل هو ( جزءٌ من المدينة ) ص 8 ، وإن ابن باجة يشيرُ إلى رؤية أفلاطون للحياة المنزلية المشتركة ، وللمشاعة الأسرية ، حيث يتمُ إلغاء الملكية الخاصة ، وتتشاركُ المجموعاتُ الأسريةُ في الملكية العامة ، وبهذا فإن تدبير المنزل هو جزءٌ من تدبير المدينة ، وإن المنزل الكامل هو ذو الملكية الجماعية ، ومن هنا نفهم عبارته في هذا السياق الغامض والتي يقولُ فيها : ( إن الزيادة فيه نقصان . وأن سائر المنازل ناقصة بالإضافة إليه ومريضة ، لأن الأحوال التي تباين بها المنزل الفاضل تؤدي إلى هلاك المنزل وبواره ، ولذلك تشبه المرض ) ، (4) .
إن المنزل الاجتماعي الراهن والذي تسودُ فيه الملكية الخاصة واللامساواة هو منزلٌ ليس فاضلاً كما نفهم من نصه ، (فإنه إن خلا منزل من ذلك لم يكن أن يبقى ولا كان منزلاً إلا باشتراك الأسم . فلنترك القولَ فيه ولنعرجَ عنه لمن تفرغ للقول في الأمور الموجودة وقتاً ما .) ، (5) .
ورغم إنه هنا يقولُ بإنه سيدعُ أمر المنزلِ إلا أنه يواصل التعبير عنه بهذا الشكل اللغوي المضطرب ، ويخلصُ إلى القول : (وهو بينٌ أن القول فيه جزءٌ من القول في تدبير الإنسان نفسه) ، (6) .
إن ابن باجة وهو يقطعُ علاقةَ أفكارهِ بأصولها الأفلاطونية لا يوضحُ بأن المقصودَ بها هو نظرة أفلاطون إلى الحياة الأسرية المشاعية ، وأن الأسرة المشاعية هي أساس المدينة الفاضلة التي يتوخى الحديث عنها ، فهي الأساس الأسري والاجتماعي لتكوين مدينة فاضلة انتفت منها الملكيات الخاصة ، وبهذا فهو يعبرُ بالألغاز عن أفكار عبرعنها الفارابي في مدنه الفاضلة سابقة الذكر (7) ، ثم يضطربُ مرة أخرى فيقول : (فمن ها هنا تبين أن القول في تدبير المنزل على ما هو مشهور ، ليس له جدوى ولا هو علم ، بل إن كان فوقتاً ما ، كما يعرض ذلك فيما كتبه البلاغيون في كتب الآداب التي يسمونها نفسانية مثل كتاب كليلة ودمنة ومثل كتاب حكماء العرب ، المشتملة على الوصايا المشورية ) ، .
إنه لا يريدُ أن يعبرَ عن فكرتهِ بوضوح وكون الحياة الأسرية المثالية مرتبطة بإنتاج ملكية مختلفة عن الملكية الخاصة وعن تربية الأطفال السائدة ، فينقضُ نصَـه السابق بكون تدبير المنزل جزءٌ من تدبير النظام الاجتماعي العام ، المراد تشكيله بديلاً عن النظام الفاسد الراهن ، فلا يعرض شيئاً آخر ويتوه في زقاق فكري جانبي ، فلا نعرفُ ما المقصود بإدراج كليلة ودمنة في معرض الحديث عن تدبير المنزل والمدينة ؟
فكليلة ودمنة تتعلقُ بحكايات رمزية ذات هدف إصلاحي يستهدفُ تغيير الدولة والمجتمع من منطلق خاص ، (9) ، لكننا لا نرى تحليلاً يربطُ ما بين وضع الأسرة والمدينة في جمهورية أفلاطون وفي كليلة ودمنة ، حيث يتوجه أفلاطون إلى تشكيل مجتمع مثالي خيالي ، في حين يقومُ ابن المقفع بنقد السلطة المطلقة للأسد – الملك ، وإذا كان كلاهما يتجهان للإصلاح فعلاً فمن منطلقات مختلفة كثيراً ، لكن ابن باجة لا يقومُ في كتابهِ بهذا التحليل ، وهنا نجدُ الثغرات المتعددة التي تــُتركُ بين الأفكار والرموز المحللة والكتب المُستشهد بها .
وسنرى لاحقاً لدى ابن رشد كيف تتم عملية تكميل مشروع ابن باجة هذا ، خاصة من زاوية تحليل جمهورية أفلاطون ، ومقاربتها للمجتمع الإسلامي (10) .
وبعد هذا العرض المأخوذ بتصرفٍ مرتبك من أفلاطون والفارابي ، فابن باجة يتوجه بسرعةٍ شديدة لوصف المدينة الفاضلة بأنها (تختصُ بعدم صناعة الطب وصناعة القضاء) (11) ، دون أن يمهد لعرض طبيعة هذه المدينة الفاضلة إنتاجاً وعلاقات اجتماعية وسياسية ، فيندفع لوصف جوانبها الشديدة المثالية وغير الواقعية وخاصة ما يتعلق بإلغاء علم الطب !
ويعلل ذلك بقوله :
( وذلك أن المحبة بينهم أجمع فلا تشاكس بينهم أصلاً ، فلذلك إذا عري جزءٌ منها من المحبة ووقع التشاكس احتيج إلى وضع العدل واحتيج ضرورة إلى من يقول به ، وهو القاضي ، وأيضاً فإن المدينة الفاضلة أفعالها كلها صواب . . ولذلك لا يتغذى أهلها بالأغذية الضارة . .) ، ( 12) .
إنه وبعد أن عزل الأسس التي أقيمت عليها هذه المدينة الفاضلة يقومُ بعرضِ مزاياها الخيالية ، حيث كمالها غير المبرر يؤدي إلى ظاهرات مثل غياب القضاة والأطباء ، لأنه لا توجد صراعات فيها ، ولا توجد أمراضٌ ويتصور بأن الأمراض كلها ناتجة عن سوء الغذاء ، ومتى ما كان الغذاء صحياً فلا طريق إلى تسلل الأمراض إلى هذه المدينة الكاملة .
وأما المدن الأربع الناقصة فإنه يجري فيها مثل ذلك ، وهنا لا ندري عبر هذا الكتاب ما هي المدن الأربع ، فالمؤلف لم يعرض كما قلنا بتسلسلٍ واضح أفكار المعلمين السابقين الذين يستقي منهما هذه الأفكار .
وهكذا يقارن بشكلٍ متكررٍ ودائم ومتقطع ومتداخل بين هذه المدن الأربع والمدينة الخامسة – النموذج المطلوب ، فالعادات السيئة والشريرة كالكذب والفساد كلها في المدن الأربع ، ويمثل (النوابت) الشكل الاجتماعي الغامض لكل هذه الشرور :
(فبينٌ أن من خواص المدينة الكاملة أن لا يكون فيها نوابت ، إذا قيل هذا الاسم بخصوص ، لأنه لا آراء كاذبة فيها ، ولا بعموم ، فإنه متى كان ، فقد مرضت وانتقضت أمورها وصارت غير كاملة) ، (13) .
ونظراً لسيادة المدن الناقصة فإن التغيير كما يراه ابن باجة يكون عبر تشكل نموذج أفراد هو الذي أطلق عليه اسم كتابه (تدبير المتوحد) فهؤلاء الأفراد يقومون بفعل التدبير المتوحد الذي يشكل تلك (النظافة) الأخلاقية والاجتماعية الطوباوية التي يدعو لها ابن باجة ، ولكن من الممكن أن يكون المتوحد أكثر من فرد ، وأن يكون ثمة متوحدون ، (ما لم يجتمع على رأيهم أمة أو مدينة) ص 13 ، فمن الممكن في رأيه أن ينمو هذا التوحد ويشكل فعلاً جماعياً ، ولكن كيف وهم أفراد متوحدون ؟
(لأنهم ، وإن كانوا في أوطانهم وبين اترابهم وجيرانهم ، غرباء في آرائهم ، قد سافروا بأفكارهم إلى مراتب أخر هي لهم كالأوطان ، إلى سائر ما يقولونه .) ، (14) .
2 ــ النفس والأخلاق
وبخلاف الفلاسفة المشارقة المسلمين الذين يبحثون صورة الذات الإلهية كما يتخيلونها ويتحدثون عن الفيض الغيبي ، فإن ابن باجة كما رأينا في الفصل الأول يتوجه لبحث معنى عنوان كتابه ، متوجهاً إلى الإنسان المفرد ، كي يدعوه إلى نظرة معينة ، هي أن يكون مختلفاً في مدن الشر والفساد ، وفي الفصل الثاني يكملُ هذا البحث متجهاً إلى بحث النفس والأخلاق.
إنه لا يأتي بجديد أثناء عرضِ أصناف النفس ومستوياتها حيث النفس المغذية والمولــِّدة والنامية ، وكذلك لا يأتي بجديد في العلاقات المتداخلة بين الكائنات ، وكون الإنسان هو تتويج الكائنات الحية كما تطرح الفلسفة الدينية عامة ، كذلك فإن رؤيته لكون الزهد والسمو الأخلاقي هو جوهرُ الكائن الإنساني ، هو أيضاً متابعة للفارابي وغيره ، لكنه يقومُ بالتغلغل في جوانب جزئية لهذا السمو ، عبر رؤية التداخل ما بين (البهيمي ) والإنساني ، ويصيرُ المتوحدُ هنا هو القادر على الصعود المستمر من الأفعال البهيمية نحو الكمال الأخلاقي ، لكن لا نجد ذلك الانسحاب من المجتمع والأنزواء ، كما أن الغيبيات الكثيفة حول النفس لا نجدها لدى ابن باجة بل أن المتوحد هو إنسانٌ داخل الحياة الاجتماعية ، أما النفس الكونية والعجائبية لدى الفلاسفة المشارقة فإنها تغدو هنا مجرد نفسٍ إنسانية فردية بسيطة تسعى للارتفاع بأفعالها عن الخسة وعن الأعمال غير الأخلاقية ، جاعلةً هذه الأفعال الخيرة هي بؤرة وجودها .
هنا نلمحُ الفردَ المنتمي للفئات الوسطى وهو يستشعرُ فرديتــَهُ ويرفضُ المدنَ الأربع الرديئة التي نفاها الفارابي ، لكن ابن باجة لا يتحدثُ عنها بوضوح ، ويظلُ ملتفاً بجملٍ غامضة ، داعياً الأفراد المتشابهين (المتوحدين) إلى التماثل الأخلاقي المثالي .
ولا شك أن هذه الدعوة هي بحدِ ذاتها لغةُ تعارضٍ مع الدولةِ منتجةِ الفساد العام ، ولهذا سنلاحظ كيفيةَ تشكل اللغة الفكرية لابن باجة كلغةٍ منولوجيةٍ تلخيصيةٍ تحليلية متقطعة متنامية ، كمحاولةٍ لبلورةِ معنىً نقدي مضطرب .
3 ـــ العقل والصورة
إن ابن باجة يواصلُ تلخيصَ الفلسفة الأرسطية والمشرقية فيتحدثُ في فصل (القول في الصور الروحانية ) عن الروح والنفس اللتين يراهما كتكوينٍ واحدٍ ، ويلخصُ رؤى من سبقوه بقوله :
(والروحاني منسوبٌ إلى الروح . . ويدلون به على الجواهر الساكنة المحركة لسواها ، وهذه ضرورة ليست أجساماً ، بل هي صورٌ لأجسام . .) ، (15) وفي هذا نجدُ استمرارَ رؤية الروح كجوهر ، وليس كعمليات ، ولكن ابن باجة ينعطفُ بالتعبير نحو جانبٍ جديدٍ فهذه الجواهر ليست أجساماً بل صوراً ، أي هي عملياتٌ عقلية داخلية في وعي الإنسان ، وبهذا فإن ابن باجة يفارقُ غيبيات الفلاسفة المشرقيين ويتجاوزُ تشكلَ الروح كما تتمظهرُ في ما وراء الطبيعة وبالشكل اللاعقلاني السائد ، ويحددُ أنواعَ العقول المؤسسة أرسطياً ومشرقياً كالتالي :
(والصورُ الروحانيةُ أصنافٌ . أولها صورُ الأجسام المستديرة ، والصنف الثاني العقل الفعال والعقل المستفاد ، والثالث المعقولات الهيولانية ، والرابع المعاني الموجودة في قوى النقس ، وهي الحس المشترك وفي قوة التخيل وفي قوة التذكر) .
ويكررُ ابنُ باجة ما هو معروف ، ولكنه يعرضُ جانباً منها بصورةٍ جديدة أيضاً ، فالعقل المستفاد هو متممٌ للعقول وللصور المادية في عقل الإنسان ، فهو يتشكلُ عبر تلاقحٍ جدلي بين الأشياء والعمليات وبين الفكرة ، فهو غيرُ منفصلٍ عن مرئيات الواقع ولا عن النمو الفكري الداخلي في الإنسان .
في حين يغدو العقل الفعال هو (الفاعل لها) ص 21 ، أما الصنف الرابع الموجود في قوى النفس والحس المشترك والتخيل (فهو وسط بين المعقولات الهيولانية والصور الروحانية) ، (16) .
يتضحُ هنا كيف أن ابن باجة يعقلن الصورَ والأفكار الروحية الميتافيزيقية ، فيقطعُ الماورائيات الغيبيةَ الكثيفة ، فهو يقولُ عن صورِ الأجسام المستديرة ، وهي الكواكب والنجوم التي تلعبُ دوراً حيوياً في الفلسفة المشرقية : (وأما الصنفُ الأولُ فنحن نعرضُ عنه في هذا القول ، إذ لا مدخل له فيما نريدُ أن نقوله ) ، ص 22 .
إن إزاحة هذا الدور يتم هنا بغموض كذلك ، فهل هو تأجيلٌ للبحث أم إلغاءٌ من التأثير؟
لا نعرف ذلك ، وهو يواصلُ هدمَ غيبيات الفلسفة المشرقية حين يأتي لدور العقل الفعال الذي يأخذُ لديه :
(وإنما نستعملُ في هذا القول الروحاني المطلق ، وهو العقل الفعال وما يُنسبُ إليهِ ، وهو المعقولات . وأسمي في هذا القول هذه المعقولات بالروحانية العامة ، وأسمي ما دونها أي الصور الموجودة في الحس المشترك ، الروحانية الخاصة ، وسيتبينُ بعد ذلك هذا لمَ أخصُ هذا بالخاصة وتلك بالعامة) ، (17).
وإذ لا يهتم ابن باجة بالتشكيل الغيبي للعقل الفعال فهو يهتمُ بتكونه الموضوعي المادي ، فنرى تركاً لمتابعة العقل المفارق وتركيزاً على العقل الأرضي .
فالصورُ الروحانيةُ العامة التي جاءت من العقل الفعال (لها نسبة واحدة خاصة ، وهي نسبتها إلى الإنسان الذي يعقلها . أما الصورُ الروحانية الخاصة فلها نسبتان . إحداهما خاصة ، وهي نسبتها إلى المحسوس ، والأخرى عامة ، وهي نسبتها إلى الحاس المُدرك لها ، مثال ذلك صورة جبل أُحد عند من أحسه . .) ، (18) .
وبعد أن قطع ابنُ باجة العلاقات الغامضة الغيبية بين العقل وما وراء الطبيعة ، فإنه يبحثُ في الفصل الثاني مدى يقينية تلك الصور المعرفية ، ومدى مطابقتها للحقيقة التي تتجسدُ لديه في الواقع .
ولكي تكونُ الصورةُ صادقة فلا بد أن تتجاوزَ ضعفَ الحواس :
(فإن الحسَ قد يكذب . مثالُ ذلك ، حس المحرورين بالأشخاص التي يخاطبونها حسٌ كاذبٌ . وكذا طعم أصناف من المرضى كاذب ، والإنسان بالصور الورحانية المختلطة صادق وكاذب وأفضل الصور الروحانية ما مر بالحس المشترك) ، (19) .
وتمثلُ ذاكرة الحس المشترك الجوانبَ الانعكاسية المباشرة من الطبيعة والمجتمع والأشياء ، ثم تغدو الصورة أقل جسمية في الذاكرة ، ثم تنتفي علاقتها المادية المباشرة في (القوة الناطقة) ، حسب التعبير بالرموز عن الصور .
إن الصورَ تتصاعدُ من الخاص إلى العام : (فإنه كلما وُجدت النسبة الخاصة ففيها جسمية) ، فإذا ارتفعت الجسمية وصارت روحانية محضةً لم يبق إلا نسبتها العامة) .
وإذا كانت الصورُ تتشكلُ عبر الحس السليم فإن ابن باجة يقولُ أيضاً أنها تتشكل عبر الحدس ، ولكن (هذه فلا تكون باختيار إنسان ، ولا له في وجودها أثر يدخلُ في هذا القول . وأيضاً فإنها موجودة في الفرد من الناس في النادر من الزمان ، فلا يتقوم من هذا الصنف من الموجودات صناعة أصلاً ولا نحوه تدبير إنساني ، فلذلك لا مدخل له في هذا القول) ، (20).
فإذا كانت المعرفة الصادقة هي نتاجُ الوعي المباشر والمتصاعد من الحس المشترك إلى اللغة ، فإن الحدس لدى الفيلسوف هو عملية نادرة فردية تتم بشكلٍ غير إرادي ، ولكن هذه الحدوس لدى المحدثين وأصحاب الرؤى: (فهي زائدة على الأمر الطبيعي لكنها مواهب إلهية . وهذه لا يحدث عنها صناعة ، لأنها في الأقل من الناس . بل الأمر الطبيعي هو التوسط ، وهو وجود الظن مختلطاً ، وأفضل هذه الوجودات أن يكون أكثر ظنونه صادقة وأن لا تختلط ، إلا فيما شأنه ذلك ، (21) . فالحدوسُ لا يمكن الاعتماد عليها في بناء نظرة عامة للمعرفة .
تتجهُ نظريةُ المعرفة عند ابن باجة إلى الاعتماد على الحس والمحسوس وتصعيد دورها ، فيقولُ بأن (اليقينية من محمولات الصور الخاصة ، فهي المحمولات التي توجد أشخاصها في الصور الجسمانية ، ولذلك ترك بالحس) ، (22) وهذه العملية المعرفية هي التي تنطلقُ من الحواس التي تتعاونُ مع بعضٍ لتكوين الصور ، ولكنه لا يكتفي بها فقط بل أيضاً يدخل الفكر (وربما احتيج إلى القوة الفكرية كذلك ) ، ص 28 . وكذلك ينشأ القياس من الصور ومن تداخل الوعي ، ص 28.
إذن عبر الحواس والفكر والقياس تتشكلُ المنظومة المعرفية :
(فلذلك إذا اجتمعت القوى الثلاث حضرت الصورة الروحانية ، كأنها محسوسة ، لأنها عند اجتماعها يكونُ الصدقُ ضرورةً ويشاهد العجب من فعلها) ، (23).
إن انفصال الفكر عن الحس قد تتمظهر عنه : (صورٌ غريبة ومحسوساتٌ بالقوة هائلة المنظر وأنفس أحسن كثيراً مما في الوجود) ص 23 ، وعلى هذا النحو من التضخم الصوري – النفسي أدرك الغزالي الأشياءَ ، كما يواصل التحليل ، ثم يصلُ إلى هذه العبارة الخطيرة في الفلسفة العربية الإسلامية :
(ولذلك زعم الصوفية أن إدراك السعادة القصوى قد يكون بلا تعلم ، بل بالتفرغ وبأن لا يخلو طرفة عين عن ذكر المطلق ، ولأنه متى فعل ذلك أجتمعت القوى الثلاث وأمكن ذلك ، وذلك كله ظن ، وفعل ما ظنوا أمر خارج عن الطبع . وهذه الغاية التي ظنوها إذن لو كانت صادقة وغاية للمتوحد ، فإدراكها بالعرض لا بالذات ، ولو أُدركت لما كان منها مدينة ولبقي أشرف أجزاء الإنسان فضلاً لا عمل له ، وكان وجوده باطلاً ، وكان يبطل جميع التعاليم والعلوم الثلاثة التي هي الحكمة النظرية ولا هذه بل والصنائع الظنونية كالنحو وما جانسه ) ، (24) .
عبر (اليقين في محمولات الصور الروحانية بالذات) ، وعبر (الأخبار وتواترها ) (واجتماع القوة الفكرية مع القوة الذاكرة) وأن هذه كلها إذا لم (يتحد مع الحس) : (لم تحضر صورة الشيء كما هو في الوجود) ، ص 30 .
ولكي يغدو متوحد ابن باجة غير متوحد الصوفية عبر هذه النظرية المعرفية التي تكشف العالم الموضوعي ، لا بد له من أخلاقيات مختلفة :
(ونحن إنما نقصدُ فيما نحن بسبيله تدبير المتوحد ، ومن الصور الروحانية الكاذبة يكون الرياء والمكر وقوى أخر شبيهة به ) ، (25) .
تغدو وسائل الكذب والتمويه المتسعملة من قبل القوى المسيطرة فضائل عند المخدوعين بها ، ولهذا فإنهم كما يقول ابن باجة يفضلون معاوية بن أبي سفيان على علي بن أبي طالب ، وفي هذه الانعطافة السياسية الفكرية لدى الفيلسوف تترابط قضايا الوعي الأخلاقي بالبنى الاجتماعية العربية ، حيث كانت كل الرذائل وطرق التفكير المتداخلة معها هي أشكال الوعي والسلوك لدى الأشراف الحاكمين ، في حين تكون لدى المتوحد نقائضها .
فكلما ازدادت الفضائل والمعرفة كلما هيمنت على المتوحد روحانيته لا جسمانيته ، فيغدو التطور الروحي الأخلاقي هو أساس التكوين البشري ، رغم أن ذلك لا ينقطع عن الاهتمام كذلك بالجسد .
والطابع الاجتماعي لدى ابن باجة لعملية تشكل الفضائل والمعرفة واضحة فهؤلاء الجسمانيون المتوقفون عند الحس يتجسدون في هذه الأوصاف :
(التأنق في أنصاف المطاعم والروائح) ، (السُكر ، ولعب الشطرنج ، والصيد للالتذاذ) وبطبيعة الحال فمن يستطيع ذلك هم (الصنف القليل من الناس) .
ولكي يوضح تماماً وجودهم الاجتماعي يقول :
(وهذا الصنف إنما يوجد أكثر في أعقاب ذوي الأحساب . وعلى أمثال هؤلاء ينقطع ثبوت شرف الإنسان . ولذلك إنما ينتقلُ الهولُ عن أجناس الأمم على أيدي هؤلاء) ، (26) .
هذا هو التقييم الفكري – الثقافي لمسيرة هيمنة الأشراف على المعرفة والأخلاق ، فهذه السيطرة تقود إلى فقدان الشرف ، وبطبيعة الحال فإن التدهور (الهول) يتشكلُ عبر هذه السيادة التي تفرغ العرب والمسلمين من ذلك الاهتمام بالمعرفة والسمو بالروح .
ويواصل ابن باجة كشف الطابع الاجتماعي عبر التحديد السياسي لأصحاب الحسب ، فيقول :
(وذلك موجود كثيراً في هذا الزمن الذي كتبنا فيه هذا القول ، وكان في هذه البلاد في سيرة ملوك الطوائف أكثر . وهؤلاء يعرفون بالمتجملين ، وتلقب هذه السيرة بالتجمل ، فلذلك يقال أن التجمل يذهب بالمال ، ويتوسلون به في حوائجهم عن أكابرهم ويهرجون ويمرجون بها) ، (27 ) .
هكذا عبر الزهد والتطلع إلى الجوانب الروحية الرفيعة وترك مباذل المتع ودون إزالة تطلعات الجسد الإنسانية ، يتكشف المثقف التحديثي الطالع من صفوف الفئات الوسطى ، وهو يتوجه للمعرفة ويشكل منهجاً يقوم على (التفكير الاستدلالي والاحتجاج المنطقي ) كما يصف هنري كوربان الفلاسفة اليونان ، وفي مواقع أخرى تلامذتهم العرب المسلمين ، (28)
وهو الآن يتحدث عن الفضائل الأخلاقية والاجتماعية التي سيدها أهلُ الأحساب ، وهو يقرأها بشكلٍ عامٍ تجريدي مثالي ، فهو يواصلُ القولَ عن ذوي الأحساب وأخلاقهم :
(وجميع الآراء المكتوبة والراقية مطبقة على ذم هؤلاء الناس) ، ونلاحظ كلمة (الراقية) تعطينا فصلاً بين نمطين من القوى الاجتماعية ، حيث يغدو أهل الأحساب معبرين عن تدهور اجتماعي ، لا عن رفعة ، وتتجسد عملية التدهور في الوضع المادي المعيشي أولاً عبر الملابس وأحوال المساكن ووضع المأكل والمشرب ، وعبارات ابن باجة هنا عامة غائمة :
(وقليل ما توجد له هاتان مفردتين ، لكنه أكثر من الأول . وإنما عـُدت هذه نبلاً لمواقع الصور الروحانية منها . وعلى أمثال هؤلاء تنقرضُ الدولُ في الأكثر) ، (29) .
وهو يقصدُ هنا بأن الكثير من الناس لديه هذه الصور المعيشية وهي تراها (نبلاً) حيث هي صورة (الرقي) المتعارف عليها ، ونلاحظ هنا الخميرة الفكرية التي ستغدو عند ابن خلدون بؤرة مركزية في تاريخه الاجتماعي .
ومن هذه الصور ما تكون الطبقة الحاكمة به المظاهر ويـُقصد منه الانفعال ، أي التأثير الاجتماعي ، (كلباس السلاح في غير الحرب ومالعبوس وسائر الهيآت النفسانية ، وفي هذا يدخل ما يصنعه الملوك عندما يدخلُ إليهم العامةُ والغرباءُ عنهم كالرسل . .) ، (ومنها ما يقصد الالتذاذ كالشتم والتودد ، والبر ، والهزل داخل في هذا الصنف ، وكثير من الملابس والمساكن التي تيعجب منه) ، (ومنها ما يقصد به الكمال فقط ، وأن عرض فيه بعض هذه فالبعض ، وهي الفضائل الفكرية وهي العلوم والعقل) .
وهو يرى بأن هذه (يـُقصد منها أن تولد في النفس خشوعاً ، فتعقبه الكرامة وسائر الخيرات) ، (30) .
إن كل هذه الجوانب (الأخلاقية) يقصد منها الخضوع ، وتظهر الثقافة الرفيعة في البلاطات هذه كظاهرات جانبية ليست من صلب وظيفتها .
كذلك فإن (العمل الفاضل) جزءٌ من هذه الصورة الأخلاقية المكرسة في عمل النخب والحكومات هذه ، ومعيارها أن تكون للحق والفضيلة ، وهو هنا يستشهد بحديث نبوي حول الهجرة وكذلك حديث (إن الأعمال بالنيات ولكل أمرئٍ ما نوى ) . إن ابن باجة يحول مسار البحث في الأخلاق إلى مسار ديني مثالي ، بدلاً من أن يواصل الحفر في الإرث العربي الإسلامي بالشكل الاجتماعي السابق .
ثم يواصل تعداد الفضائل المشكلة لتطور الروح كالتعليم وصنع المكرمات لذاتها ، ويجعلُ الثقافة الرفيعة تتويجاً لهذه الفضائل : (فقد تلخص أمر المدينة جملةً في العلم المدني ، والروية والبحث والاستدلال وبالجملة الفكرة ، تسعمل في نيل كل واحد منها) ، (31).
4 ـــ السيرة والفكرة
في عرض ابن طفيل لفكر وحياة ابن باجة نقرأ السطور التالية :
( . . ولم يكن فيهم أثقب ذهناً ، ولا أصح نظراً ولا أصدق رويةً ، من أبي بكر بن الصائغ . غير أن شغلته الدنيا حتى اخترمته المنية قبل ظهور خزائن علمه ، وبث خفايا حكمته . وأكثر ما يوجد له من التآليف ، إنما هي كاملة ومجزومة من أواخرها ، ككتابه في (النفس) و(تدبير المتوحد) ، (32)
ويضيفُ ابن طفيل انتقادات أخرى لأسلوب ابن باجة المفكك عادة ، ونستطيع أن نضيفَ إليه بأنه أسلوب غامض ومتقطع ومتكرر وهو يغزلُ على معاني أرسطو وكتبه ، ولكنه أيضاً يتوغلُ في قضايا عميقة رابطاً بني الأفكار العامة حو العقل والحياة الاجتماعية ، متجنباً الغيبيات ،محللاً نسيجَ الوعي بشكل فكري ، مقترباً من ربطهِ بشبكة الحياة الاجتماعية ، مبرزاً صوتَ المثقف المعارض لغيبية الصوفية ، (33).
إن كل هذه الجوانب السلبية والإيجابية في أسلوب ووعي ابن باجة تجعله بداية للفلسفة الأرسطية العربية وهي تظهرُ بشكلٍ مدرسي تلخيصي لمنهجية أرسطو ، لكنها تضعُ أساساً للقراءة الموضوعية للطبيعة والمجتمع اللذين غرقا في التبعية لما وراء الطبيعة ، وبهذا فإن تعبير ابن طفيل عن ابن باجة بأنه شغلته الدنيا ، يمكن أن نأخذه كتعبير عن انقطاعٍ مفاجئ لحياته قبل أن تتاح له الفرصة للتعبير ، ويمكن أن نأخذه كشكلٍ تعبيري للصراع بين توجهات ابن باجة العقلانية وتوجهات ابن طفيل الصوفية المنقودة والمرفوضة لدى ابن باجة ، وهذا ما دعاه لنقده بتلك الطريقة .
إن ابن باجة وهو يشكلُ مثل هذا الوعي العقلاني متجاوزاً النصوصية الدينية المحافظة مقدماً للنصوص الدينية رؤية أخرى ناقدة لبذخ أهل الحسب ، وعبر الاستشهادات من القرآن والحديث النبوي ، ورافضاً من جهة أخرى الرؤية الصوفية ، وعبر هذا الحفر في الوسط الاجتماعي المرئي المدروس التي تظهر نوابضه وسببياته من داخله ، لا من الاتصال بالعقل الفعال والفيض من النفس الكلية ، يكونُ قد شكل طريقاً مغايراً لابن طفيل الذي سيعلي من الشطح الصوفي كتتويج للمعرفة ، ويكون قد مهد السبيل لابن رشد كي يعمق هذا المسار الفكري وبشكل واسع ومتين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الاسلامية الجزء الثالث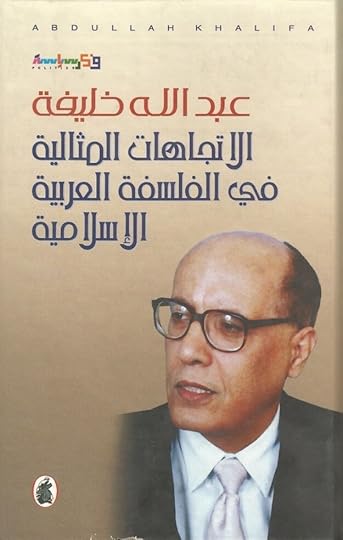
المصادر :
(1): (تدبير المتوحد ن ابن باجة ، سراس للنشر ، 1994 ، تونس ، ص4).
(2): (المصدر السابق ، ص 6).
(3): (المصدر السابق، ص8).
(4): (المصدر السابق، ص .
(5):(المصدر السابق ، ص 9).
(6):(المصدر السابق، ص9).
(7):(راجع فصل الفارابي في هذا الكتاب ، فقرة المدن الفاضلة).
(8):(تدبير المتوحد، ص 9).
(9) : (اقرأ في ذلك فصل ابن المقفع في الجزء الثاني من هذا المشروع)
(10):(راجع فصل ابن رشد ، في هذا الجزء).
(11)،(12): (تدبير المتوحد ، ص 10).
(13):(المصدر السابق ، ص 12 . وكان تعبير (النوابت) القدحي قد استخدمه الجاحظ ضمن من استخدمه لتتنديد بالجماعات الدينية المتشددة ، راجع : فصل (من أفكار الجاحظ الفكرية والفلسفية) في الجزء الثاني من هذا المشروع، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ، 2005).
(14): (المصدر السابق ، ص 13).
(15): (المصدر السابق ، ص 20).
(16): (المصدر السابق ، ص21).
(17): (المصدر السابق ، ص 22).
(18): (المصدر السابق ، 22 ).
(19): (المصدرالسابق ، ص 24).
(20): المصدر السابق : ص 25) .
(21): (المصدر السابق ، ص 26) .
(22) : (المصدر السابق ، ص 28 ) .
(23) : ( المصدر السابق ، ص23 ).
(24): (المصدر السابق ، ص 29 – 30).
(25): (المصدر السابق ، ص 31 ).
(26) : (المصدر السابق ، ص 40) .
(27) : (المصدر السابق ، ص 42 ) .
(28) : (تاريخ الفلسفة الإسلامية ، مصدر سابق ، ص 322) .
(29) : (تدبير المتوحد ، ص 41).
(30) : ( المصدر السابق ، ص 43 ) .
(31) : ( المصدر السابق ، ص 57 ) .
(32) : (وضعت دار النشر فقرة ابن طفيل في المقدمة).
(33) : (فتنكب ابن باجة عن هذه الاعتبارات ، وبين أغاليط الغزالي ، واعتبر دعوته للتصوف والعزلة خداعاً للناس وتضليلاً ، لأن العالم العلوي ، لا ينفتحُ للمتصوف المتنسك الواهم ، وانما يطل عليه العقل الباحث عن كمال ذاته ، المصدر : أهلا الفلسفة العربية ، مصدر سابق ، ص 653).



