عبـــــــدالله خلــــــــيفة's Blog: https://isaalbuflasablog.wordpress.com , page 23
January 10, 2024
ابن رشد : كتب ــ عبـــــــدالله خلـــــــيفة
December 29, 2023
أدب الطفل في البحرين: مسرحية الأطفال عند علي الشرقاوي كتب ــ عبدالله خليفة
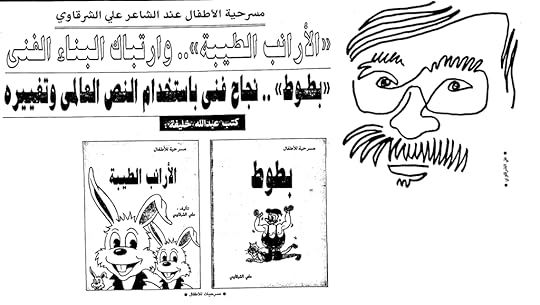
إذا كان علي الشرقاوي شاعراً ومبدعاً متميزاً . وإذا كان ناجحاً في تأليف أغنية الأطفال. ذات البساطة العميقة. والصور الجميلة المشبعة بظلال الحياة والعمل. والايقاعات السهلة، الراقصة، فإنه في تأليف مسرحية الاطفال يواجه صعوبات عديدة وإشكالات تمنعه من صياغة دراما ناجحة للأطفال.
في مسرحية «الأرانب الطيبة»، يشكل مسرحية من ثلاثة فصول طويلة، تقع في 72 صفحة من القطع المتوسط، الأمر الذي يجعل المسرحية تستغرق عدة ساعات.
وهذا التطويل في البنية الفنية، سببه اشكالات التركيب وتعثر بناء الحكاية.
فالمسرحية تكشف في الفصل الأول من صفحة 3 إلى 25 ، عن مجيء ثعلب الى الغابة والتقائه بأسرة الارانب، فيقرر أن يعيش في ذات المكان، اكلا الأرانب واحداً واحداً، وزاعماً أنه يريد بناء بيت للأرانب، في حين كان يستولى على أرضهم، وكذلك كثيمة فنية ورمزية للاستعمار.
وفي الفصل الثاني نجد أن البيت قد بُنى . وتحول إلى ما يشبه المؤسسة، ومديرها العام هو «الخروف». وهنا تتجه احداث المسرحية الى التيه، وتتراكم اللقطات الجزئية دون بناء فني.
ففي بداية الفصل الثاني نجد عراكاً بين القطة والكلب والخروف في عدة صفحات دون فائدة أو أهمية فنية. بينما يظهر أب الأرانب وامهم بعد عدة صفحات تالية، ونجد أن الصراع بين الثعلب والأرانب لم يعد هو مدار الصراع المسرحي. فقد صارت الفكرة الآن هي سيطرة الثعلب: على كل شيء في الغابة، ويظل مجيء الحيوانات الأخرى كالحروف، الذي أسيء اختياره تماماً كمدير عام! والكلب، والقط، هامشياً وغير مؤثر في الصراع.
وحين يظهر الأب والأم المسئولان عن اسرة الارانب، نجد أن صغيرين من الأسرة قد اختفيا، فيلجأ الأب والأم إلى الذئب – الوزير، عبر مقطع طويل، هو الآخر بين 34 – 40، لكن الثعلب يرشو الذنب – الوزير، فلا يفعل شيئاً لمساعدة الأرانب.
وتدخل الذئب، مثال على طريقة نمو الحبكة، فالذئب يظهر فجأة ويختفي بذات الصورة، دون أن تكون له لمسة درامية خاصة على البناء، ويصير حواره الطويل، على مدى خمس صفحات، اضافة الى ترهليه أخرى.
كذلك كان مجيء الأسد، عبر مقطع طويل، بعد ان استعان به الأب والأم، اضافة ترهليه اخرى. لقد رشاه الثعلب أيضاً وخرج دون ان يترك اثراً.
وفي نهاية المسرحية فإن الأرانب تكتشف ان الثعلب يأكل الصغار ويدفن عظامها كما يفعل بالدجاج والطيور.
أن الحبكة الأساسية جيدة، ولكن تم إدخال عدة محاور. ولقطات جزئية جانبية، وحوارات ثانوية، وشخصيات زائدة، مما أرهق البناء الأساسي، واضعف تشكيله.
فلو أخذنا الفصل الأول، على سبيل التشريح الموضعي، لوجدنا أن ثمة مقدمة يظهر فيها «المخرج» ليلقي خطبة طويلة عن أعماله، ثم يشرح فنه للأطفال قائلا:
[قال البعض عن مسرحياتي انها مخلوطة أي للكبار والصغار وأتصور ان السبب الاساسي في هذه النتيجة هو عدم مشاركتكم وطرح أرائكم بصورة حقيقية حول هذه المسرحية] !
اضافة الى تحول المقدمة الى ترهل أول، فإنها ضد فن المسرح وفن مسرح الطفل خصوصاً، عبر تحولها الى مناقشة فكرية فنية، ليست بمستوى الصغار، كما ان إقحام شخصية المخرج في بدء العرض وخلال المسرحية كلها، كان سلبياً.
وبعد هذه المقدمة، وافتتاح المسرحية عن الفصل الأول، نجد مجموعة من العصافير تتحدث طويلا عن إيقاظ الأرانب، وإذا كانت أغنيتها مناسبة وجميلة كافتتاح مشرق للنهار، فإن الحوار وحبكة الحدث لا أهمية له. فالأغنية وحدها كانت غنية بالتعبير.
وحين تصحو الأرانب، الشخصيات المحورية في العرض، يحدث حوار طويل كذلك حول النهوض الصباحي والرغبة في رؤية الأم وإفساد الحلم وحب الأكل والجزر، وهو حوار مطول بلا توظيف. ولا تبدأ الدراما الا عندما يأتي الثعلب مهدداً إياهم وراغباً في أكلهم !
ولا نجد للأرانب شخصيات محددة، ولا نجد للأب والأم خصائص متميزة، لكن الثعلب يتميز ببعض الخصائص الشخصية العامة الفنية، كحيوان مفتون بالأكل وتاجر طريف متنقل.
ان كل هذه الحوارات المطولة في الصفحات العديدة، كانت فوائدها الفنية قليلة، فقد رسمت لنا موقع الأحداث، ثم أوضحت الشخصيات الرئيسية، وهي الأرنب والثعلب، وكان يمكن تكثيف الحوارات الى اقصى حد ممكن.
ويمكن تلخيص صفات مسرحية الأرانب الطيبة بأنها: الترهل، ضياع المحور الحدثي الأساسي، عدم تنمية الحبكة بصورة فنية دقيقة، والتيه في سراديب جانبية، واخفاق الصراع المتطور النامي.
خذ هذا الحوار كمثال على عدم خلق اللغة الدرامية:
الأرنب الثاني: تصوروا. انني حتى هذه اللحظة لا اعرف ما هو عمل أبي الارنب.
الأرنب الثالث: ولا أمي ايضاً.
الأرنب الأول: لكنهما حدثونا (؟) عن عملهما عدة مرات.
الأرنب الثاني: نسيت.
الأرنب الرابع: ما أكثر ما تنسى.
الأرنب الثالث: هل تعرف انت؟
الأرنب الرابع: نعم. أمي تشتغل في المستشفى.
الأرنب الثاني: لكن ماذا تعمل؟.
الأرنب الرابع: لا اعرف. فقط اعرف انها في المستشفى.
الأرنب الاول: ابي يعمل سائق شاحنة.
الأرنب الثالث: لكن ما هو عمل أمي. هل هي طبيبة ؟ .
الأرنب الأول: لا.
الأرنب الثاني: ممرضة ؟
الأرنب الأول: لا..) الخ..
ورغم طول المقطع، فإنه بلا تأثير أو قيمة فنية، فعمل الأب أو الأم غير المعروف، لا يساهم بأي دور، أو لا يؤدي بالأرانب إلى اكتشاف شيء جديد، أو دخول ميدان عمل، أو المساهمة في حبكة الأحداث الخ..
وخلافاً للمسرحية السابقة، فإن مسرحية «بطوط» المكتوبة سنة 1983، والصادرة سنة 1990، عن وزارة التربية والتعليم، والمعدة عن قصة هانز أندرسن «فرخ البط القبيح»، والتي لم يذكر الكاتب شيئاً عن الأصل الأجنبي اقتباس أو اعداداً، توضح الفروق بين النصوص العالمية في أدب الطفل إنتاجنا المحلي، وبين مسرحية الشرقاوي السابقة «الأرانب الطيبة» المفككة، ضائعة الملامح، وهذه المسرحية الدقيقة، الكثيفة الرؤية، وبسيطة العرض واللغة.
تنمو الحكاية نمواً دقيقاً، وتظهر الشخصية المحورية بطوط، متميزة بضخامتها الجسمية وقبحها، وقوتها، ويسبب هذا التميز حسدا عند الإخوة الآخرين، فيدبرون المؤامرات لطرده وابعاده.
وإذ يعيش البط في سلام وعمل مثمر، فإن القطط تعيش على خطط العدوان وخرق المواثيق، ويصور الشرقاوي هنا الصراع بين المعتدين والمنتجين المسالمين. ويتشكل بطوط الشرقاوي عبر التميز الجسدي الهائل والانتصار في الألعاب والقوة. ويرفض الهروب بعيدا عن وطنه الذي نفاه، بل يقاتل القطط ويتشكل ويعود. ويتشكل بطوط.
ولكن اللوحات العديدة التي اضافها الشرقاوي الى قصة هانز أندرسن كانت باتجاه قوته الجسدية الخارقة، وتشكيل علاقة غرام سريعة وناجحة وضحلة مع البطة الكحيلة.
كذلك بدا انتصاره الفردي الساحق على القطط العدوانية سهلا وسريعا.
ان «فرخ البط القبيح» لهانز اندرسون يتجه اتجاها آخر فبدلا من التسطيح السياسي يحوله إلى نموذج يلتقي بشخصيات عديدة، كلها تضطهده، وتصغر من وجوده، وهو المتميز عميق المشاعر مرهف الحس .
ان فرخ اندرسن يتشكل عبر الغربة والألم والنفي. وهو شخصية نموذجية غنية، ذات تميز جسدي، ونفسي بالدرجة الأولى، فهو قبيح الشكل فقط، لا قوة سوبرمان كفرخ الشرقاوي، وقبحه الشكلي الخارجي يتنافر ويتضاد مع عاطفته المرهفة «الإنسانية»، وحبه للسفر والحرية والبحث والاغتناء الداخلي. كما انه نموذج للمضطهد المكافح الذي يأخذ مساراته الداخلية من نموذج البطل اليتيم الفقير المضطهد في الحكاية السحرية الشعبية.
في حين ركز الشرقاوي على الحركة الخارجية: الالعاب، الطرد من الغابة، العراك مع القطط، صناعة الشباك المصيدة، والانتصار على العدو، حبكة الحب/ الزواج.
وبالتالي فإنه اتجه الى الدلالات الظاهرة المباشرة للقصة الأصلية، ولم يعمقها عبر التركيز على نمو شخصية الفرخ القبيح وانتقالاته وضغوط النماذج الرديئة على شخصه.
لكنه حافظ على دقة الكلمة، وتنمية الحبكة بصورة دقيقة وسريعة، وارتبطت معظم الشخصيات بالمحور الحدثي المتنامي.
يتبع أدب الطفل في البحرين: وطن الطائر لـ خلف أحمد خلف
December 28, 2023
أدب الطفل في البحرين : قصة الأطفال عند إبراهيم بشمي كتب ــ عبدالله خليفة
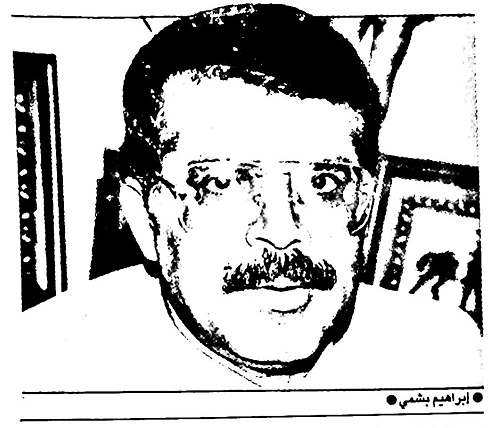
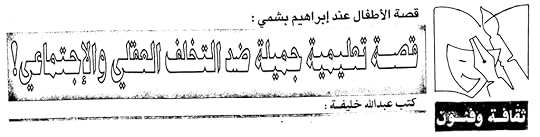
إبراهيم بشمي من أكثر الكتاب البحرينيين انتاجاً لقصة الأطفال، فلديه أكثر من ثمانية إصدارات لقصص الأطفال، وكلها ذات لغة سهلة، مرحة، هادفة، ومنها «العصفور الأعرج»، «سراطين البحر الجبانة»، «الزهرة الزرقاء»، «فرخ البط الخواف»، «جزيرة الطيور»، «النبع المسحور»، «اللؤلؤة السوداء»، «طائر الكيكو».
ويتجه القاص إبراهيم بشمي في كتاباته الموجهة للأطفال، إلى تشكيل حكاية ذات مغزى واضح، وعبر لغة مبسطة، ذات صور وظلال جميلة، وتتركز شخصياته على الحيوانات والطيور، مستهدفاً خلق عبرة.
واغلب قصصه في هذا المنحى التعليمي، وتتجه قصصه ذات الطول الأكبر، إلى توسيع نمط الحكاية وتعميقها، وخلق بنية أكثر تطوراً، تذوب في جزئياتها الإرشادات التربوية والاجتماعية الواضحة المباشرة.
في قصص مثل: سراطين البحر الجبانة، مهرجان الضفادع، فرخ البط الخواف، السلاحف الثرثارة، الاصدقاء، نجد الحكاية المصاغة بغرض التوجيه التعليمي، مستهدفة قضايا جزئية متعددة.
في «مهرجان الضفادع»، نشاهد لوحة صغيرة عن مجموعة من الضفادع، تنهض في عتمة الليل، حيث جميع الكائنات نائمة، وتقوم بالنقيق واللعب.
في البدء يظهر القمر المنير، متذمراً من الغيمة التي حجبته عن الظهور ومشاهدة العالم. وهذه اللقطة الافتتاحية وبطلها القمر سرعان ما تختفي، ليتم التركيز على الضفادع التي قفزت في بركة الماء وراحت تصيح وتغني.
و ليس ثمة حدث خاص بهذه الضفادع سرى اللعب «البريء»، ولكن هذا اللعب والزعيق في منتصف الليل، يزعج الكائنات الأخرى، فها هي السلحفاة تخرج رأسها وتزعق طالبة الهدوء. لكن الضفادع لا تلقي اهتماما لتذمر الآخرين وانزعاجهم، وتواصل اللعب ورش الماء والضحك والقفز. فيتسع الانزعاج من شغبها الليلي، وتتذمر العصافير قائلة: ان لديها أعمالا في الصباح تريد قضاءها، وهي ليست مستعدة للأصغاء الى هذا الضجيج المزعج، كما يصرخ الديك الذي يطالب هو الآخر بالهدوء، لأنه على موعد قبيل طلوع الشمس. ولا يستطيع أن يسكت الضفادع النقاقة سوى حذاء قديم يندفع من يد فلاح ينهض غاضباً من فراشه.
وتتضح بنية القصة التعليمية، من هذا الابتعاد الكلي عن شخوص الضفادع وذواتها وكون النقيق يعبر عن حالة «انسانية»، خاصة بها. ومن التركيز الشديد على الصراع بين الضفادع وبقية الكائنات، حيث تندفع الضفادع إلى اللهو بقوة. وفي كل مقطع، يظهر صوت، يؤكد على أهمية الليل للراحة والاستعداد للعمل. فالضفادع تظهر في مقطع، وتناقضها السلحفاة في مقطع تال، وتظهر بعدئذ العصافير وتصارع الضفادع. ومن ثم الديك، واخيراً الفلاح. وتتضح الغاية التوجيهية التعليمية من هذا التصاعد في المعترضين للضفادع، فكل منها يسعى لغاية هامة عملية في النهار، في حين لا تستهدف الضفادع في ضجيجها ليلاً سوى اللعب وليس الإنتاج.
واذا كانت السلحفاة لم تقل سوى «ألا تنامي؟ اخفضي صوتك المنكر رجاء»، فان العصافير أوضحت الغاية أكثر بقولها: «إن لدينا أعمالا كثيرة في الصباح»، كذلك فعل الديك عندما قال: «أريد النوم قليلاً، حتى أصحو قبل طلوع الشمس».
وتنعزل كافة الجوانب الأخرى من ذوات الضفادع وطبيعة عملها الليلي الخاص بها، والمرتبط بكينونة خاصة، وشخصيات الكائنات الأخرى ونفسياتها المتفردة، ليتركز السرد في تبيان طبيعة الليل وكونه خلق للنوم والاستعداد للعمل، في حين خلق النهار للعمل والإنتاج. وهذه وظيفة بشرية رتبها الناس في ظل ظروف انتاجية طبيعية خاصة، وتحولت هنا إلى توجيه، تجسد في كائنات، ليست لديها هذا الترتيب الخاص. لقد حدثت تناقضات بين المادة القصصية والمادة العلمية، لكن لصالح التوجيه التربوي. ولا تهم الكاتب المطابقة بين المادة القصصية والمادة العلمية، بقدر ما يهمه تسريب توجيهاته الوعظية داخل بنية القصة.
ولكن داخل البنية القصصية تحققت السياقات الناجحة، عبر هذه الفرشة المتعددة للطبيعة والكائنات المختلفة وتنامي الصراع، عبر لغة سردية مرنة، اوصلت الوعي إلى الأهداف المطلوبة.
ومثل هذه البنية تتكرر في قصص اخرى مثل «السلاحف الثرثارة»، حيث نجد الفقرة الأولى تحتوي على مضمون القصة كل: [كانت السلاحف في ذاك الزمان البعيد.. كبيرة الحجم.. مشهورة بالكسل والثرثرة.. والقيل والقال.. ورغم سخرية الحيوانات من ثرثرتها إلا أنها لم تترك هذه العادات السيئة].
في هذه الفقرة الافتتاحية نجد لتضاد واضحاً بين السلاحف وبقية الحيوانات، وهو على سياق التضاد التام بين الضفادع وبقية الكائنات في القصة السابقة. ونجد سبب الاختلاف بيناً واضحاً أيضاً، وهو يتركز في التباين بين السلاحف كحيوانات ثرثارة، وبقية الحيوانات غير الثرثارة.
وتغدو بنية القصة التالية تطبيقاً لهذه الافتتاحية، فسرعان ما يأتي نبأ عاجل بقرب جفاف الوادي، واستعداد الحيوانات المتعددة الكثيرة للرحيل. ماعدا السلاحف التي تسخر من هذه النبوءة. ويأتي عالم الحيوانات الأخرى، المقدم كأمثولة ونموذج، متكاملا من حيث الاستعداد و استكشاف المكان التالي، وتجهيز المؤونة. في حين أن عالم السلاحف، والمقدم كمثل سيء يجب ان لا يحُتذى، ويبدو معادياً لعالم التخطيط والمعرفة ولاهيا في يومه واكله المتواجد الحاضر.
ويبدأ السرد في التركيز على هذا الجانب، فينمو الصراع والاختلاف حول رؤية المستقبل، حين يجادل الهدهدُ السلاحف الصغيرة غير الواعية لما يدور – وهي نموذج للشباب في الأمة – فيقول الهدهد [ألم تعرفوا بعد ان الأمطار لن تسقط في هذا العام وسيعم الوادي الجفاف؟]. وحين لم يعرفوا وقد عاشوا على تربية الجهل من قبل السلاحف الكبيرة، ينتقل الهدهد إلى بؤرة القصة ومضمونها [يبدو أنه حقيقة ما يقال عن جماعة السلاحف بأنها كسولة وثرثارة.. ولا تتعب نفسها بالتفكير بالمستقبل والاستعداد له].
ان الثرثرة تتطابق هنا مع فقدان التخطيط وتضييع الغد، وتبدو السلاحف الكبيرة – العرب، نموذجاً للعادة السيئة هنا، كما كانت الضفادع نموذج العادة السيئة هناك. ولكن العادة السيئة في هذا النموذج أكثر غوراً وأشد خطورة ومرتبطة بكيان الأمة.
ويتضح أكثر طابع المحور الحدثي – القصصي، حين يحدث انشقاق في عالم السلاحف نفسه، بين السلاحف الكبيرة السن، والسلاحف الصغيرة. الأجيال القديمة والأجيال الشابة. ولكن من أين أتى هذا التباين؟ [قالت إحدى السلاحف الثرثارة معلقة على رحيل السلاحف الصغيرة : انها تكرر عبارات جديدة وأفكاراً (؟) غريبة نتيجة اختلاطهم (؟) بالغرباء من الطيور].
وهكذا تغدو السلاحف الصغيرة رمز الأجيال الشابة المتوثبة لتبديل الماضي، وهي نفسها مقدمة امثولة للأطفال ونماذج للاحتذاء. وسرعان ما تتضح الأمثولة. والنهاية الحتمية للتخلف، السلاحف الكبيرة تدخل بياتها الشتوي، فلم تعد تعي ما يدور، فتشققت الأرض من الجفاف، والأعشاب اصفرت ويبست، وجف النبع.. وماتت الاسماك.. وحين انتبهت لم تجد شيئا غير الحرارة.. والزوال.
هكذا تتجه القصة الأمثولة نحو المشكلات الأبعد، والأكثر عمقاً وجذرية. فلم تعد المشكلة صياحاً في الليل وازعاجاً، بل نماذج معتادة على تضييع الزمن وعدم التفكير في المستقبل. وتبدو هذه العادات السيئة نتاجاً لاختيارات وعادات سلوكية بالدرجة الاولى ومن الممكن تبديلها، عبر هذا التباين بين الجيل الهرم والجيل الفتي.
ولا تتناقض هنا المادة القصصية والمادة العلمية. بل تبدو متسقة ومنسجمة. وتتوغل قصص الامثولة أكثر في المشكلة الاجتماعية المعروضة. فهي لا تصبح فقط عادة سيئة، بل فقداناً للقدرة على الصراع ضد الاعداء، و استكانة في مواجهة الأخطار الاجتماعية لا الطبيعية فحسب.
فهذا ما يحدث لـ«السراطين الجبانة». فهذه السراطين كانت تعيش بسعادة ولهو في واديها الجميل في اعماق البحر. ولكن حين جاء الأخطبوط ذو الأذرع الكثيرة و«العيون» الجاحظة غدت مادة شهية له. ورغم قوة أجسادها وذراعها، إلا أنها كانت تستسلم بسهولة للعدو.
ويتضح محتوى القصة – الامثولة في الحوار بين الحلزون والسراطين «إلى أين ترحلين ايتها السراطين الحمراء؟. فتجيب: نبحث عن وطن. يرد الحلزون ملخصا الحكاية: لماذا لا تدافعون عن انفسكم ووطنكم».
لقد طرح الكاتب في البداية العادات الاجتماعية كجذور لتخلف كائناته، ولكن الخلفية السياسية الأبعد، راحت تطرح ذاتها على بُنى القصص، لتغدو معا بنية مجتمع الحيوانات المتخلف – التابع، شكل التجلي لواقع الامة. فتغدو السراطانات امتدادا للضفادع والسلاحف، أو مظاهر متعددة للأمة، الفاقدة للوعي الحضاري المعاصر وقدرة الدفاع عن ذاتها، حتى تعيش قرب الساحل حيث تكثر المجاري والأوساخ، فتبهت أشكالها وتتقزم أحجامها.
في قصة «اللؤلؤة السوداء» المطولة، والصالحة للفتيان، نرى حكاية الامثولة التعليمية، بشكل أكثر اتساعا وتطورا، وببنية متعددة السياقات.
في البدء نقرأ، ذات الافتتاحية القديمة «كان يا ما كان في قديم الزمان، أميرة جميلة تعيش في قصر والدها سلطان بغداد…»، وهو نفس الموتيف القديم، حيث ثمة خلل ما في قصر الخلافة، وفي مركز هذا القصر، حيث الأبنة المدللة مركز الكون القصصي. وفي ذات سياق الموتيف القديم، يسارع السلطان نحو ابنته المكتئبة، مستعداً لعمل أي للقضاء على حزنها.
لكن الكآبة لم تكن لفقد كائن حبيب، أو نتيجة لمرض مزمن. بل لفقدان عقد من اللؤلؤ الأسود الثمين. وهنا يفارق القاص بشمي طابع القصة القديمة المؤثر والعميق، مدخلاً فقدان العقد اللؤلؤي، غير المهم. نظراً لأن أي فتى يدرك مبلغ الثروة الخيالية لسلطان بغداد حيث الامبراطورية ومركزها.. فلا يغدو العقد اللؤلؤي. موقداً لنار الحدث الحكائي المعاصر المنتظر.
ويظهر الموتبف القصصي القديم الثاني، حين يعلن السلطان أن من يجلب العقد سوف يتزوج ابنته. وهنا وقعت بنية الحكاية في اشكالية. فقد كانت الحكاية القديمة منسجمة مع ذاتها، فدعوتها لمساعدة الأميرة والزواج منها، معاً، لا تظهر إلا للجلل الخطير من الأمور. كالمرض المزمن أو الكآبة المستعصية على الأطباء والحكماء. أما فقدان عقد ليس به تميمة ما، أو سر خطير، فليس سبباً معقولاً لان يعلن السلطان تزويج ابنته لمن يعثر عليه. فلا شك أن ابنته اغلى من العقد.
ومهما كان الجدل التبريري الذي جرى بين السلطان ووزيره، حول شكل الدعوة ومصداقيتها، فإن كل المبررات التي طرحها الوزير، غير معقولة. وقد ظهر هذا الارتباك في السياق القصصي نظراً لان الكاتب لم يستفد من البنية القصصية القديمة العميقة الكبيرة.
فالحكاية القديمة كانت تضع الإنسان في بؤرتها القصصية، وليس العثور على اللؤلؤ والذهب مهما كان ثميناً. فشفاء الأميرة وانقاذها هو ما كان يحرك ويلهب السرد والأحداث.
لكن القاص اراد ان يكسر طريقة الحبكة القديمة، وأن يطرح الخطاب الأيديولوجي المعاصر في موادها الممزقة، فيُظهر ان الاغنياء أنانيون وسيئون، وأن الفقراء وحدهم هم من يقومون بالأعمال الباهرة الشجاعة، وهذا هو نموذجهم الكلي القدرة، «عناد»، القادم من مدينة صغيرة في الخليج، الذي يتطوع، لا لكي يسلي الأميرة. بل لينقذ أصحابه الفقراء الغواصين. وحين يجلب اللؤلؤة السوداء يرفض الزواج من ابنة السلطان بل وحتى استلام المكافاة المالية!.
[هذه بطبيعة الحال من أعمال إبراهيم بشمي القديمة، في أواخر السبعينات] لكن رغم المآخذ التكوينية، على هذه القصة، إلا أن الكاتب يتناول هنا مادة تاريخية تراثية، برؤية مختلفة، وعبر شخصيات بشرية، متعددة، وفي مساحة جغرافية متلونة متباينة، بانيا حكاية متنامية مشوقة.
يتبع.. أدب الطفل في البحرين : مسرحية الأطفال عند علي الشرقاوي
December 25, 2023
الرواية بين الإمارات والكويت(4 من 4): وبدرية لــ وليد الرجيب ــ كتب: عبدالله خليفة
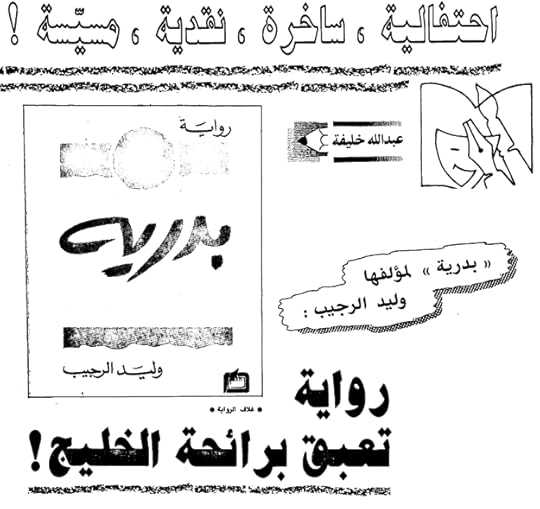
تصوغ رواية «بدرية» لمؤلفها وليد الرجيب راوياً جماعياً لعالم التحول في المدينة الخليجية، التي طلعت من عالم البحر والصحراء تواً، عبر بناء قصصي – قصير، متتابع، يعبر عن عالم التحول وصراعاته، بحيثياته الحقيقية وترميزاته المستقبلية، جامعاً بين التسجيل الفلكلوري والبناء الروائي المتقطع.
الراوي الجماعي والمحور الروائي:
يظهر الأطفال في الرواية كراو جماعي لكل الأحداث التي تقع في الرواية. ورغم أن الرواية تبدأ براو فردى، هو الروائي /المؤلف، إلا أن هذا الراوي الفردي للقصة، يسلمنا ـ بعد عبارة قصيرة ـ الى الراوي الجماعي، الذي يقودنا في احداث المدينة/ الحي وتحولاتهما الكبيرة.
أنه يقول في أول الرواية (بعد انتهاء بحثي وتحرياتي.. بعد عودتي.. بعد اثنتي عشر سنة. أمسكت بقلمي وكتبت) ص 20.
فهذا الراوي الفردي، هو المؤلف نفسه، الذي سافر الى أمريكا للدراسة، ويرجع الى مدينته ليراها قد تغيرت كلياً، وتحولت من المدينة البحرية الصغيرة الى مدينة النفط الجديدة.
وهذا الراوي الفردي، سيظهر، ليس في نهاية الرواية فقط، ليختمها بنبرة حزينة تفاؤلية، بل سيتدخل كذلك في مساعدة الراوي الطفولي الجماعي، حين لا تسعفه أدوات الفهم والتحليل، لتفسير الأحداث، أو متابعة أجزاء خافية منها.
فلدينا في الحقيقة راو واحد، هو المؤلف، الذي كان صغيراً وجزءاً من الوعي الجماعي الطفولي، ولم يكن متميزاً داخله، فيعبر، بلسان هذا الجمع الغفير من الأطفال، عن لحظات طفلية في تطور المجتمع الكويتي ـ الخليجي العربي، ثم ليتجاوز هذا الوعى الطفلي، مكتشفاً أبعاداً جديدة في الحياة، بعد أن اغتنت معرفته ـ رؤيته، وهو كبير. فهو راو محيط بكل شيء، على مستوى الماضي أو الحاضر.
هذا التباين داخل وعى الراوي، هو جزء من مرحلتين من مراحل تطور المجتمع، كان فيها التطور على ضفاف الطبيعة الاجتماعية البكر، ثم اخترق الضفاف، ليصعد فوق هذه الطبيعة.
يباغتنا الراوي الجماعي الطفولي، بحيويته، وبراءته، وسخرياته وغنائيته الشفافة. لقد روى كل لحظات الحياة الاجتماعية الطفلية، مثل ألعاب الأطفال، ليالي الأعراس، صيد البراري، ظهور السينما الخ..
إن الكورس الطفولي الجماعي هو الذي يرى هذا العالم الاجتماعي الطفولي، النابت تواً، والمتناسق الوجود، والمتناقض كذلك. فالرؤية الفنية هنا، لن تضفي طابعاً رومانسياً على تناقضات الحياة، بل سوف تبرزها، ولكن ستشكل تلك الوحدة، التألفية الشفافة في «الشعب» في تلك الحارات الفقيرة البسيطة.
ومن هنا فهذا الكورس، هو طفولة هذه الحارات، وعلاقاتها الحميمية، عندما كانت متناغمة مع بعضها البعض في رحم الوجود الطبيعي ـ الاجتماعي، الطالع من برية وبحر الخليج.
سنرى هذا الراوي وهو يروي لنا الاحداث، ويصف الشخصيات، ويشكل في رويه العفوي، قصصاً عديدة، وفي كل قصة، ثمة شخصية، هي جزء من هذا الحي الشعبي، الذي لم تغيره، بعد، تطورات المرحلة النفطية التالية.
في هذا الروى سوف يعتمد على بساطته، ولغته العفوية، الجامعة بين اللقطة التصويرية المباشرة، وتجسيد شكال الفلكلور، وصياغة الحدث الروائي المتقطع، المتصاعد.
وهو أحياناً، سيتخلى عن الطفولية، ليعود إلى وعيه الناضج، المتأخر، واصفاً الاشياء والاحداث التي تتجاوز وعى ذلك الطفل الجماعي.
خلال تفسيره اللاحق، الاجتماعي، ليدمج بين الراوي الجماعي الطفولي، والراوي الفردي .
وسنرى أن الراوي ليس هو إلا الراوي الفردي، أو الروائي، وقد لبس انفعال الطفولة وبصرها، واستعاد حيويتها ومرحها، ثم قطع هذا الانفعال، في لحظات معينة، حين احتاج المعمار الروائي، تدخلا جديدا ومختلفا وذا تحليل.
اول ما يصفه هذا الكورس، بحب غامر، هو بدرية: الشخصية المحورية في العمل والرمز.
ان «بدرية» تظهر منذ البداية، باعتبارها رمزا، فرغم سنوات الطفولة البسيطة، إلا أنها تتصرف وكأنها تجسد الحب والعدالة على هذه الارض.
فهي تكره الإنجليز المحتلين، وهي جميلة، وعذبة الحديث، ومرحة، وجريئة، ولم تخجل إلا مرة واحدة عندما سألها احدهم وصدرها يتكور «صدرك فيه حليب؟»! ص 24. وهي تساعد الجميع، فتمشط شعور البنات، وتكنس أفنية المنازل، وتشترى الحاجات للناس، وتحمل الرسائل الغرامية للشباب، سواء كانت «مكتوبة أو شفوية»، وتساعد الداية «أم شملان» في الولادات، وتقود العاب الاطفال. وتروى الحكايات بطريقة ساحرة.
لكن من أين كونت هذه الذات الرائعة؟ يخبرنا الراوي الجماعي، انها بلا والدين رسميين ووجدت هكذا في الحى: ابنة للناس. ولم يجد اهل الحى غضاضة في حياتها الطفولية الهائمة بل فتحوا لها بيوتهم وغرفهم، وصارت كابنتهم الجماعية.
تتوحد بدرية بكل ما هو جميل و«نقي» في هذا العالم الشعبي، الطيب، وكأنها تموز، وقد صار انثى، أو الزمن الربيعي الجميل السعيد، وقد تجسد فتاة. إنها تغدو صورة هذا العالم النقي، وبراءته وخضرته.
ورغم ان كل الأطفال يحبونها، إلا انها تفضل «فهدا». فهذا الفتى الصغير، الذي مات والده أثناء غرق السفينة، يساعده العامل «فلاح». لكي يعمل في شركة النفط، ليغدو هو المستقبل المنتظر لـ«بدرية».
لكن بين بدرية وفهد، يقف «بونشمى»: الرجل الغني، المقاول، الموظف اللاحق، ممثل رأس المال المتنامي ابداً في هذه المدينة البحرية المتغيرة.
ان «بونشمي» أحد المحاور الهامة في الأحداث، والمدينة، وهو الذي تتجمع في يديه خيوط الثروة والنفوذ، وقد وصفه، في البدء، الراوي الجماعي، وهو يدخل السوق، وترتفع أيدى الجميع محيية إياه، في حين استغل الراوي الجماعي الطفولي، الفرصة ليملأ جيوبه بالطماطم والخيار، ثم يقف بين يدى بونشمي وكأنه حرس محييا اياه، وتأتى «رومية» المغنية الراقصة لتحييه.
لكن هذا الراوي سرعان ما ينقطع ليظهر الراوي الفردي الحديث، بسرده الاجتماعي التحليلي، لينقب في ثروة بونشمى ومصادرها، وليصف رحلته إلى البصرة بهدف تحميل ثمن بلح النخيل الذي يملكه، وزيادة مساحة بساتينه، وزواجه من فتاة عراقية صغيرة وجلبه لصبي جديد وجميل.
لكن هذا الراوي الاجتماعي التحليلي الحديث، سرعان ما ينقطع هو الآخر، ليعود الراوي الجماعي الطفولي ويصف ذكريات الأعياد وكيف يقوم «بونشمي» بتقديم زريبة من الأضاحي لأهل الحي.
هكذا يتعاقب ويتضافر ويتقاطع الرويان المختلفان، ليشكلا بنية السرد – الوصف – الحوار، وليجسدا الأحداث والشخصيات المختلفة.
أن الراوي يقف، هنا، عند هذا المثلث الأساسي: بدرية – فهد – بونشمى. ليتغلغل في الروافد التي يشكلها هذا المثلث. ففهد حين يعمل في شركة النفط، لا يكون هناك من مقاول يجمع الانفار للشركة. سوى بونشمي ذاته. وتفلح وساطة «فلاح» لكي يتغاضى بونشمي عن سن الصغير الذي سرعان ما يتوغل في أجواء العمال المتعبة، ويعيش حياتهم البنائية القاسية.
ومن هذا المحور الروائي الدرامي، سنتعرف على شخصيات تنمو في سياقه، «كابو عيسى»، معاون بونشمي وساعده الأيمن في التوظيف والترجمة والتسجيل والمشاورة، وهندرسون مدير الشركة، والصراعات «النقابية» الأولى، وسيتسع المكان الروائي لنرى منطقة السينير الجميلة المخصصة للموظفين الإنكليز، ونرى حياة العمال الصعبة، ومجيء السينما إلى البلد، وشجار العمال والانكليز في أحد العروض السينمائية، ونلمح تأثير فلاح الفكري على فهد، ثم إبعاد فلاح عن الشركة بعد معركة الضرب في السينما التي قادها ضد الانكليز الخ..
ليس لهذا الجانب من قيمة سوى في كشف أبعاد تطور «فهد» في هذه الطبقة الجديدة التي تتشكل في المجتمع، والتي سنجد فيها امتداداً لتلك الانسجامية التآلفية القديمة للحي الشعبي. وسرعان ما ينقطع هذا الجانب من المثلث، ليظهر جانب «بونشمي».
ان بونشمى المزواج، يتعرف الى بدرية حينما جاءت تحاول إعادة فلاح المفصول والمضروب الى الشركة، فيتمعن فيها بونشمي ويشتهيها ويرغب في ضمها الى حريمه، ويتمكن من ذلك ولكن لا يستطيع أن ينام معها.
حين يحدث زواج بونشمي – بدرية، يكون ذلك فرصة مناسبة وكبيرة، للراوي الجماعي والفردي، لكي يحتفيا بهذه المظاهر الشعبية والطقس الاحتفالي الواسع، بدأ من الطبخ إلى الغناء وإلقاء الشعر.
ولا يستطيع بونشمي «أن يدخل» على بدرية، رغم محاولته للاستعانة بعيسى الذي نصحه بضرورة العودة الى الراقصة المغنية «رومية»، لكي تثير همته، لكنه وجدها عجوزا شمطاء، وبقى عاجزا، رغم تحول المدينة البحرية الصغيرة الى مدينة مالية كبيرة، يجمع هو الكثير من خيوطها في يديه، ورغم مرور العديد من السنوات على هذا الحدث. ومن جهة أخرى. فان بدرية تواصل حبها الشفاف لفهد، عبر الرسائل، الى ان يمرض بونشمى وتطلب بدرية الطلاق قبل وفاته بقليل، في وسط ترحيب وسعادة زوجاته الاخريات واولاده بهذا الطلب المتأخر. ثم تتزوج بدرية من فهد وتحمل منه، لا من بونشمى!
هذا هو المحور الروائي في الرواية أو هو الخيط الدرامي المتصاعد، القائم على صراع بونشمي – فهد، الذي يتكون عبر حلقات صغيرة، اغلبها يتركز في صراعهما الاجتماعي – العاطفي الثنائي.
لكن اذا كان الصراع الاجتماعي بينهما قد توارى بعد نمو المدينة، حيث لم يكن فهد سوى عامل صغير في شركة النفط، بينما بونشمى مالك أساسي في المدينة كلها، فإن صراعهما العاطفي حول بدرية ظل مستمرا، وبينما يفشل بونشمى في الإنجاب من بدرية ويموت مهزوماً. فإن فهدا ينجح في عملية الإخصاب «الاجتماعي».
ان هذا المحور يقوم بتجسيد الشخصيات كرموز واضحة ، فبدرية تظل هي الارض، الخصب، التي لن تكون للغنى بونشمى، وصاحب القحط الاجتماعي، بل هي من نصيب المنتجين المخصبين.
ولكونها رموزا واضحة، مباشرة، فهي لا تدخل في علاقات وتكوينات معقدة، وتظل جوانبها البارزة مسيّسة ومجسدة لهذه الاستقطابات الاجتماعية الثنائية: الفقراء – الأغنياء، الخصب – العقم، العمل – الملكية.
ويقف الراوي بوضوح ومباشرة مع الجانب الأول، واصفا قدراته القوية وبساطته واستقامته، في حين يكشف ضحالة وانانية الجانب الثاني. وهذا يقود إلى تبسيط الصراع، وادلجته، وتقسيم الشخصيات إلى ثنائية غير جدلية، دون أن تصور الصراعات العميقة فيما وراء الجانب الاقتصادي.
الراوى الجماعي والمحور الفلكلوري:
في حين يحصل المحور الروائي على ثلث الرواية، فإن المحور الثاني، المحور الفلكلوري الاحتفالي، سوف يحمل على ثلثي الرواية. فهذا المحور الاخير، سوف يتسلل الى جوانب الرواية المتعددة، ويقطع تسلسل أحداثها. ويوقف التصوير المتغلغل في شخصياتها، عارضا لوحات فلكلورية للحي وشخصياته وطقوسه واغانيه وشعره. وهذه اللوحات لن تأتي إلا في سياق المحور الروائي، وعلى ضفاف نموه، ولكنها سوف تسبب عدم تطوره.
اضافة الى الكورس الجماعي الطفولي، المعبر عن افراحه الفتية بصيد الطيور والبحث عن الفطر، واللاعب في الاعراس والليالي، والباحث عن القصص العجيبة، والمحب لبدرية، فإن هناك العديد من الشخصيات التي تظهر في سياق رويه، والتي هي جزء من عالم الحي، لا من عالم المحور الروائي رغم تقاطعها وتداخلها في سياقه.
فهناك «ابومجبل الشاوى» الراعي الذي يفتتح الرواية بمشهد غنمه، وهي تعود إلى الحي مع الغروب. ومجبل هذا لن يكون له أي دور، إلا حين يكتشف «عبادين» احدى الشخصيات الهامشية الثانوية الأخرى.
ومثله مثل «ضاوى» الجزار، الذي نجد لقطة اجتماعية عن كيفية تعامله مع البهائم المجهزة للذبح. ص 34 – 35.
وكذلك «أم نشمى» وبهائمها. ان لأم نشمي دورا في بنية المحور الروائي حيث تكون علاقة حميمية مع بدرية، لكن وجودها يتصف، بشكل عام بالسلبية والجمود. ونستغرب كيف ترى زوجها يتزوج اخريات، وهي تقف بلا حراك، بل وتشجعه حين تطلب منه أن لا يدخل على بدرية بقسوة وسرعة.
لكن هذا الوجود الروائي المضمر، يقابله وجود فلكلوري مهم، فنجد عدة صفحات تصف علاقة أم نشمي بالبهائم ص -57 -62، هي علاقة ليس لها دخل أو أثر في البنية الروائية، ولكنما مشهد فلكلوري يجسد علاقة البشر، حينئذ، بالحيوان، الذي كان جزءا حيويا من بيوتهم وعالمهم.
وهناك أيضا، (أم شملان) الحوافة، التي تقوم بدور القابلة أيضاً، كما تضع ادعية وتقوم بطقوس الزار وطرد الجن، وهي أيضا زوجة امام مسجد (ابن عويد)، وكأنها وزوجها، يمثلان البناء الأسطوري – الديني الذي يظلل المجتمع.
هذا النثر الفلكلوري لعالم المدينة، يجد تجليه أيضا في لحظات فلكلورية خاصة، مرت بالمدينة، ونموذجها حي (حولي) هنا، مثل لحظات سقوط المطر ونبت العشب، أو تحول هذا المطر الى (هدامة)، أي طوفان يهدم البيوت القديمة، ليعقبها تطور اجتماعي سريع وحاد، بإعطاء الدولة تعويضات كبيرة، واستغلال بونشمي للحدث أيضا، ويظهر الطابع الفلكلوري في عرس بونشمى حيث نشم روائح الطبخ والطيب، وليظهر الشاعران (جويعد) و(صقر ثامر).
لقد أخذ جويعد، وصقر ثامر، مشهدا قصصياً فلكلورياً، حينما راحا يتباريان شعرياً، ويقطعان تسلسل الرواية، لننتقل الى مشهد جانبي مرح وساخر.
وحتى الطبالات كان لهن مشهدهن الخاص، حيث برزت سيجارة (غازي) التي دخنتها إحداهن.
وتظهر أيضا صالحة المجنونة، في زمن اختفاء بدرية، أو زمن القحط، وهي امرأة تبيع (اليقظ والخريط والبيض) وكانت لصة سابقة، لكنها امسكت بلص جديد فاشل.
ووجدت أيضا (رومية) المغنية الراقصة، وهى الجزء الترفيهي داخل الحي، والتي دخلت الأحداث، في مقطع صغير، حينما أراد بونشمى الاستعانة بها لإثارة حميته الجنسية، ولكن هذا الإدخال لرومية، قادنا الى قصتها الكاملة، منذ ان كانت فاتنة حتى اصبحت عجوزا يتفضل عليها عشاقها السابقون بالفتات.
وحين (يتنطط) عبادين المجنون امام بونشمي صارخا عن بدرية التي سرقها بالزواج، تظهر القصة الكاملة لعبادين المجنون، وهي قصة سوف ترويها عجوز مفعمة بروح الأساطير، وعلى مدى عدة صفحات من 105 الى 111.
ويتحول حدث العدوان الثلاثي على مصر، إلى جزء احتفالي في الرواية كذلك، حين تنفجر مشاركة هذا الحي وشخصيات في الحدث، دون أن يرتبط هذا بسياق البناء الروائي.
ويتحول حدث العدوان الثلاثي على مصر. الى جزء احتفالي في الرواية كذلك، حين تنفجر مشاركة هذا الحي وشخصياته في الحدث، دون أن يرتبط هذا بسياق البناء الروائي.
وقد كان يمكن للرواية، أن تتسق أكثر لو أن بؤرتها انزاحت أكثر نحو الحي، وشخصياته، وتحول فهد وبدرية إلى شخصيتين من شخصياته العديدة المتفاعلة، كما فعل نجيب محفوظ في رواية (زقاق المدق) حين حول عباس وحميدة الى جزئيتين فنيتين في معمار الحي.
ولكن كما يحدث، عادة، في مراحل التشكيل الروائي المبكر، حين تغدو قصة الحب هيكلا ترصف فيه قصة حدث سياسي هام، أو صراعات فترة تاريخية، تغدو قصة الحب هنا، العمود الفقري لقصة كبيرة – غير منجزة بالكامل – هي قصة هذا الحى/ المدينة.
وكأن قصة الحب وضعت بقوة فوق جسد احداث طبيعية منسابة، لكنها من جهة أخرى، افتقدت الهيكل الضروري، لكى تتجمع وتشكل بنية ما.
ان لدينا محورين متداخلين متصارعين، الأول هو البناء الروائي، والذي تقع قصة بدرية في بؤرته، وهو بناء كلي، متخيل، رومانسي ثوري، وتبشيري سياسي، والثاني هو البناء الفلكلوري، الحقيقي الجزئي.
فإذا كان الأول يخط علامات التطور الأساسية في الحياة، بانقسامها بين الفقراء والاغنياء، وتراكم الثروة والسلطة في يد الأخيرين، وصراع الأولين من أجل تطوير حياتهم وحقوقهم، ويجسد هذا بالقصة الرومانسية الثورية، فإن المحور الثاني يجسد الحياة بتضاريسها الحقيقية والملموسة، بغيبيات الناس وروحهم النفعية حينا، والجياشة بالحماس القومي حينا آخر.
ولكن المحور الروائي، ذا القصة المتخيلة، وذا الطبيعة الرومانسية، يُلجم تطور المادة الواقعية الفلكلورية، عبر سيطرة (المثال الطبقي الثوري) الذي يقلل من عملية التحليل الحقيقية للحياة.
ان الرواية حين تجمع بين الجانبين، تتلمس التطور المتناقض المعقد للمدينة، بتطورها الحقيقي وأحلام مثقفيها.
وهذا يجسد منحيين فنيين مختلفين، الأول هو الروائي، حيث تتشكل شخصيات نمطية، ومحور بنائي، تنمو الشخصيات عبره، الى مسارها المرسوم في التصور الفكري، فلا يوسع هذا امتداداتها وتناقضاتها.
والثاني هو المحنى الطبيعي – النتورالي، حيث الالتقاط التفصيلي والجزئي للأحداث والشخصيات. ان هذا الجزء، حافل بالحيوية، وهو يعرض الحياة الشعبية بروح احتفالية قوية الدلالات.
تقيم الرواية امثولة جديدة لعالم الخصب/ الجدب. فبدرية، هي الترميز الواضح للقمر، للنور، للجمال هي سر حياة الحي وخصوبته. حين طلع هذا الحى تواً من عالم البحر- حيث البشر هم أطفال الطبيعة المتعاونون، وحيث الحي الشعبي قوة متضافرة، متعاونة، متجانسة.
هنا كان الخصب، والطفولة، والحب، وهنا كانت (بدرية) الترميز الجمالي لهذا العالم (النقي)، البريء والذي كانت احتمالات تطوره الخصبة كامنة فيه، حيث (فهد)، الفقير اليتيم، هو المرشح لإخصاب بدرية، أو الأرض، أو الوطن، لكن الشرير، أو الشيطان، أو الجدب، بونشمي، يظهر داخل هذا العالم، فجأة، كأنه مولود خارق داخل كيانه النظيف، فيستولى عليه، عبر أدواته القديمة، في اقتصاد الغوص، وعبر أدواته الجديدة، في اقتصاد النفط، عبر السلف، سابقاً، وعبر المقاولة والسمسرة والوظيفة حالياً، فيجدبه، وهذا الجدب له مظاهر كثيرة، مثل تمزق الحي وشجارات أهله وعداواتهم اختفاء الفرح، وأهم مظاهره هو الاستيلاء على بدرية، النور، فكأن يونشمى هو الحوتة المعاصرة التي تأكل القمر وتسل الضوء عن الوجود. ولكن البدر يُنتزع ثانية، بفضل جهود فهد، فكان العمال هم الذين يعيدون النور الى العالم، فيعود الخصب من جديد، وتحمل بدرية، مؤكدة دورة الخصب مرة أخرى، بفضل تموز العصر، أو اوزيريس، أو الدور العمالي، هذه المرة!
ورغم هذه الأسطرة فإن المؤلف لا ينساق كلية مع تجريدية الرؤية، معبئاً محتواها بتفاصيل حياتية، متلونة كثيرة، وبعملية روي مشرقة ومرحة، ولكن تبقى هذه الاسطرة للواقع، غير مستوعبة لعملية الواقع المعقدة، لتحميل بونشمي مثلا كل الشر يلغى الطابع الاجتماعي لفعله وللبناء ككل. كما يقود ذلك إلى تبسيط حركة الحياة.
ان هذه هي الرواية الاول للمؤلف، ولذا فإنها مجرد خطوة اولى في جهوده، ولا شك أنه سوف يغنيها بمادة الحياة الأكثر تلونا وغنى.
December 24, 2023
الرواية بين الإمارات والكويت(3 من 4): المرأة والقطة ـ ليلى العثمان ـ كتب: عبدالله خليفة

✤ ليلى العثمان
✤ المرأة والقطة
تدور رواية «المرأة والقطة»، حول هذه المرأة الشريرة التي تتكرر الحكاية الشعبية، لكنها هنا ليست زوجة الأب الشريرة، بل العمة، أخت الاب، وهذا التغيير يعني ان العائلة المعاصرة غدت أكثر تناقضا.
إن عناصر الحكاية بسيطة، فالشخصية المحورية: سالم، يجد نفسه في بيت تحكمه أخت أبيه القاسية والمتجبرة. والتي جعلت اباه بلا قيمة، وقد بدأت قسوتها تجاه سالم تنمو منذ أن انتزعت منه قطته الانثى «دانة»، والقتها في دورة المياه، ثم أجبرته على الزواج من حصة، الفتاة الصغيرة، ففوجئ بجمالها ورقتها، واحبها بعمق لكنه لم يكن قادراً على ممارسة فعل الرجل الخصب. وبقيت حصة هذه الممارسة دون جدوى. فوجئ سالم – مرة اخرى – بامتلاء بطنها الغريب، فاتهم أباه بهذه الفعلة المشينة وانفجرت أعصابه وبدأت ملامح جديدة لشخصية عصابية. لم تكن لها أية بوادر سابقة. وقد دعياه، أبوه وعمته، إلى قتل حصة، وتنظيف بيته الملوث. لكنه في لحظة غريبة ثالثة، وميلودرامية، اكتشف أن حصة لم تحمل من قط خارجي، أو من ابيه، أو من رجل آخر، لكن ربما .. منه !
وتوجه الى امة المبعدة عن بيت أبيه ليخبرها بهذا النبأ العظيم، وما أن رجع حتى وجد حصة مقتولة بالحبل الذي حمله ذات يوم لخنقها. وكان سبباً في اتهامه بقتلها.
إن هذه السلسلة من الأحداث، تسترجع عبر وعي الراوي، البطل، الشخصية المركزية سالم، فالشخصيات الأخرى لا تظهر إلا من خلال هذا الوعي، وهو وعى صادق، «موضوعي»، في نقله وتصويره للأحداث. وهى موضوعية تُجسد عبر أحادية الصوت، وليس بتعدد الأصوات.
تتم الاستعادة داخل المكان الذي انتقل إليه سالم بعد تلك الأحداث المتفجرة. ان مستشفى الاعصاب يتيح هذا الاسترجاع المتوغل فحسب، في الماضي، فلا يغدو للحاضر أي وظيفة فنية، وأي تداخل حدثي علائقي، مع الماضي.
وتكمن حيلة الاسترجاع والاستعادة في قضية «العلاج»، ولغة ما قبل الاسترجاع، ولغة الاسترجاع ليس فيهما تباين أو اختلاف، فلا يظهر الاسترجاع على هيئة منولوج هذياني، متوتر، يعكس طبيعة شخصية عصابية، ذات تفجر وتقطع وتوتر عال، بل تظهر بصورة انسانية هادئة، ولغة فاتنة. إن التفجر والتشظي الداخلي للشخصية لم يظهر على لغته فكانت هناك مسافة بين الشخصية واللغة.
وكأن الكاتبة هنا، هي بنفسها التي تعبر وتقص الحكاية المرضية لسالم.
ويقودنا هذا القص الى بيت سالم حيث الأب والعمة والقطة. ان سالم، منذ البدء، يروى لنا قصة صراعه مع عمته التي سحبت القطة الاليفة الجميلة من بين احضانه مرارا، ثم ألقتها في بئر دورة المياه. لكن هذا الإلقاء لم يحدث عندما تعرفت دانه على قط خارج المنزل، وحملت منه، أي حين انتفخ بطنها ورات العمة الشرسة فعل الحب وهو يروي ذلك الجسد الصغير بالحياة.
فالرواية إذن تقيم تناقضات مطلقة بين الخصب والجدب، بين الحياة والموت، بين الحب والكره، بين الخلق والعدم.
فالعمة هي هذا الرمز للجدب والخريف و الموت والكراهية، انها الصورة لكل ما هو بشع، وحين تستولي على «البيت» بعد حريق قامت به امرأة عاشقة لأبيها، فقتلته وقتلت زوجته – أي أمها – حملت هذه المرأة الكراهية الشديدة لكل ما هو قريب من الحب والخصب.
فقامت بتربية أخيها، وسيطرت عليه سيطرة مطلقة، وزوجته مراراً وأفشلت زيجاته المختلفة، فما تكاد العلاقة تقترب من الخصب والإنجاب حتى ينهار الزواج.
إن البيت لابد أن يظل، في لا وعيها، خرباً مجدباً، سواء كان هذا الخصب ولادة أم امتلاء بطن حصة، بشكل غريب ومريب.
وإذا كانت هذه المرأة، ذات صفة إطلاقية كاملة، بشعة، فإن الطرف الخير، والخصب، ذو صفات إطلاقية جميلة. فسالم هو الطيبة والحنو والخير والوداعة، انه كعبدالله بطل «وسمية تخرج من البحر»، وكوسمية، نقي، قادم من الطبيعة البكر، من الطفولة التي لم تتلوث بشر.
لكنه، في هذا البيت المجدب، ليس قادرا على فعل الخصب. فسالم حينما يحاول ان يعاشر زوجته، تندفع إلى صور العمة وهي تفترس القطة، فيرتجف ويتوقف.
ان هذه العقدة تبدو مبسطة، نظرا لبساطة الحدث. حيث السببية الواحدة لفعل الجدب وحيث واقع علاقات الشخصيات فيه، يبدو مبسطاً، لا تفاعلات متعددة فيه.
وهنا نجد طبيعة خاصة للرواية الخليجية النامية ببطء، من احضان القصة القصيرة، وهي صعوبة سيطرتها على تصوير الحياة بتعدد مستوياتها.
هنا نجد بيتا مقطوع الصلات بالعالم الخارجي، بالظاهرات والاحداث وتكمن حياته داخله، بل في مربع مكثف: سالم – العمة – حصة – الأب. وغالبا ما يتم تناول مستوى واحد من عوالمهم و علاقتهم بالعقدة القصصية، أي فعل الخصب، بينما تتوارى عقدهم ومشكلاتهم الاخرى تماماً.
بل ان هذه العقدة الأساسية لا نراها الا من خلال وعى البطل المركزي: سالم، ولا نستطيع أن ندخل أعماق الشخصيات الاخرى. ولهذا يغدو الحدث والعقدة المبسطة مسيطرين على تصوير الشخصيات والتركيز على عالمهم البيتي الضيق.
وحين يحدث الصدام أولا بين سالم وحصة، حيث يراها تتجه الى خارج الغرفة والبناء، ثم تعود متوردة منتشية، يبقى الصدام، فوق ذات العقدة، ولا يتوسع عبر العلاقات بشخصيات أخرى، أو عبر دخولنا إلى ذات حصة وهواجسها وأحلامها، أن الصدام لا يغنى لنا الشخصيات أو يدفعها باتجاهات غير متوقعة.
وحين يحدث الصدام بين سالم والعمة أو الأب، لا نكتشف مستويات جديدة من الذكريات، او الاحداث، او الاعماق المتوارية، فنبقى أيضا ندور حول ذات العقدة الآنية..
وهنا تبدو مشكلات على مستوى البناء الحدثي، توضح ضرورة واختراق هذا الشكل المحدد من العقدة، فنحن لا نعرف كيف حملت حصة، رغم عجز سالم الجنسي؟ ولماذا يتركها فجأة ليذهب إلى أمه، وهل اغتيال حصة من قبل العمة او الاب؟ أو لماذا يتأخر في شراء الخبز قبيل الاغتيال بقليل؟
الشخصيات، كالأحداث، تبدو ذات مستوى واحد، عبر هذا التناقض الاطلاقى بينها، فالعمة هي الشر، بينما سالم وحصة هما الخير، ويقف الأب مشلولا عاجزا، بلا صفة محددة، وكان يمكن أن يشكل تناقضه هذا جزءا من حركة درامية ما.. أما العمة فكانت تحمل إيماءات رمزية عديدة، وكان يمكن لهذه الإيماءات أن تنمو، عبر إعطاء شخصية العمة فرص التجلي والتلون.
يتركز ويتكثف كل شيء في الرواية، إلا بعض الاستطرادات السردية، فالشخصيات تظل قليلة ومحصورة في المربع: سالم ــ العمة ــ الزوجة ــ الأب، بل ان الضلعين الاخيرين يظهران بشكل أقل، ليتركز الحدث القصصي بين سالم والعمة. ويغدو الحدث مضغوطاً ومكثفاً، هو الآخر في تتبع الصراع بين الاثنين، وهو صراع أنى، حدثي، يتوغل قليلا في ثنايا الخلجات النفسية، وهو مقطوع الصلة بخارجه، بالواقع، بالصراعات الاجتماعية والسياسية، والحياة ككل.
كما يغدو المكان مكثفاً تماماً، عبر نمو الحدث داخل البيت، بل في غرفة أو غرفتين، ولا يلعب المستشفى كمكان الا دور التمهيد للدخول إلى المنزل.
كل هذا يجعل طبيعة الرواية هنا أشبه بالقصة القصيرة، وقد اتسعت سردا وتكثفت شخصيات ومكاناً واحداثاً ودلالات.
إن قدرة ليلى العثمان على بناء الرواية العصرية، الشعبية، المقروءة، واضحة، فهي تقوم بسبك المرتكزات الأساسية للرواية، من خلق الحدث المتنامي، المشوق، الذي تتضافر فيه لغة السرد الجميل والحوار البنائي، الدافع للحدث، وشبكة من الشخصيات المتداخلة، والمتفاعلة، لكن تبقى عملية توسيع هذا الحدث، ليعبر عن دلالات أعمق، مطروحة ومطلوبة في التجارب القادمة.
الرواية بين الإمارات والكويت(2 من 4): وسمية تخرج من البحرـ كتب: عبدالله خليفة
❈ ليلى العثمان
❈ وسمية تخرج من البحر
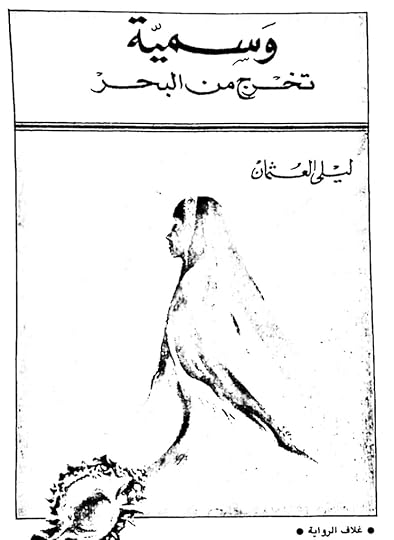
تقوم رواية «وسمية تخرج من البحر» لليلى العثمان على تقنية روائية بسيطة، فعبدالله الصياد ذو الخمسين عاماً، يتوجه دائماً إلى البحر، لكي يعمل فيه، أو يصارعه، بل كأنه يسير في طقس عاطفي، شاعري، يتحسس فيه ذاته، ووجوده.
إن المشاهد الأولى من الرواية، حين يتذكر عبدالله مدح أصحابه لصوته فينطلق مغنياً، داعياً الأسماك الى الحضور انما يستعيد فيها روحه.
في البحر هناك الاستعادة الكاملة للروح.. وف المدينة هناك الغياب الكامل للروح.. في هذا التناقض والصراع يكمن المعنى الأساسي لهذا العمل الفني، ذى البساطة التشكيلية، والعاطفية الرومانسية الشجية الملتهبة، والبنية الروائية المتناغمة.
و«البحر»، ليس بصفته الطبيعية المجردة، فهو البحر القديم، بحر الغوص واللآلئ، بحر السفن الشراعية الوفيرة، انه البحر بامتدادته الاجتماعية التآلفية، الشفافة، حين يستعيدها وعي رومانسي ، يجد الماضي اهزوجة من الحب والمشاركة.
أن عبدالله البحار العتيق، ارتبط بهذا العالم المائي الرقراق، واحبه الى درجة العشق الكامل، فهو يترك الوظيفة ليتحول الى صياد، وهو يحبس نفسه داخله رغم شجارات زوجته المشاكسة ضد هذا التواجد المريب، وضد كل الروائح التي يحملها منه، فيبقى «البحر» ضرة مستمرة لتلك الزوجة، المعادية بإطلاق للبحر،والمحبة باطلاق للمدينة، للبر…
ان المدينة، والبر، ليسا كائنين مجردين أيضا، فالمدينة هي المدينة التي اغتالت عالم البحر، هي التي مشت بتروسها وأرجلها الحديدة فوق مبانيه الجميلة العتيقة، واغتالت شوارعه وطيوره وازقته وتجمعاته.
(أين هي الآن خريطة المدينة القديمة، كل شىء نسفته الايدى باسم الحضارة.. اغتالت المباني الكبيرة طفولتنا، ودكت أفراحها) ص 13 .
فإذا كان الزوج عبدالله هو الماضي، هو السفن واللؤلؤ والدانات، وصوت عوض الدوخي، والبراحات، والعشق الرومانسي النبيل، فإن زوجته هي الفلل الحديثة، والاجهزة المستوردة، وكره العمل ورائحة البحر.
نقيضان وجدا نفسيهما تحت سقف واحد، كصراع البحر والمدينة، و الأصالة و«الحداثة»، وصراع الحب والصفقة، وصراع الماضي والحاضر، وصراع الانتماء والغربة.
وحين يتوجه عبد الله هارباً من بيت الزوجية، ومن المدينة، وتضاريسها، فاراً نحو البحر، فإنما يستعيد ذلك العالم القديم، وعاطفته المبتورة داخله، وقصة حبه التي انتهت بالفاجعة.
والقصة العاطفية، قصة حب عبدالله ابن «مريوم»، الدلالة، لوسمية ابنة التاجر الغني، هي الجزء الرئيسي من الرواية، وهي الدلالة الوحيدة، والامكانية اليتيمة، لتلاقح البحر والبر، الماضي والحاضر، الأغنياء والفقراء، الحب والعدم، في عالم الرواية.
وكونها الجزء الرئيسي من الحبكة الروائية، التي يتم استعادتها عبر فصول متقطعة، أو متواصلة كثيرة، هو الذي يعطي الرؤية الشعرية الرومانسية، إمكانيات تجليها وتجسدها.
فحين يتم القطع، والعودة الى الحاضر، يتم ذلك سؤيعاً، ومن خلال ومضات خاطفة جداً، لا تتيح امكانيات اخرى لنمو ايقاع الرواية، أو لتشكل احتمالات جديدة مضيئة للبطل، فلا تقود إلى تحليل عالم المدينة «الموارب»، واكتشاف إمكانيات جديدة لفعل البطل، وبالتالي تغلق الباب على الحاضر.
إذن فالحبكة الرئيسية تتعلق بالماضي، بقصة حب عبدالله ابن الفقراء لوسمية ابنة الاغنياء.. ففصول الافتتاح والعودة إلى الحاضر لا تزيد عن أربعة فصول من أحد عشر فصلاً، في حين تكون السبعة الاخرى متوجهة للتغلغل في تضاريس الماضي.
وتبدأ الحكاية من الطفولة، حيث الصغار المختلفو الجنس يلعبون معاً.. فمن هناك من عمق الطفولة، من تلك اللحظات التي تنتفي فيها الطبقات، ولا يوجد الا الحب والصفاء، يتأسس المضمون العاطفي الرومانسي الشفاف.
وعمق الطفولة هذا، مصاحب غريب لطفولة المجتمع، حيث التداخل الحميم بين الناس، وحيث لم ترتفع بعد، الأسوار الطبقية المحيطة العالية، تماماً كما المجتمع يعيش في حضن الطبيعة، بيوته ومواعينه وأسرته وطعامه من الطبيعة المحيطة، بل ليس ثمة فواصل بين البشر وحيواناتهم.
هنا يوجد حس الرواية الرئيسي تآلف الطبيعة والمجتمع والبشر، في عالم طفولي، شفاف، لا يعرف الفوارق والجدران والعنف.
وداخل رحم هذه العلاقات الطفلية بين عبدالله ووسمية، الطفلان الضاحكان، اللاعبان، المتشاجران .. لقد نما الحب قبل ان ينتبها لفواصل «الجنس» و«المنزل» والطبقة و«التقاليد».
وعلاقة عبدالله/ وسمية، تنمو عبر هذا المربع الصغير من بيته الى بيتها، وداخل ازقة الحي وقرب الشاطئ، ان المكان، بحد ذاته، ليس واسعاً، فسيرورته هي بين بيت وزقاق وشاطىء.. ورغم اشتغال عبدالله، فيما بعد، بين البحارة، إلا أن السفينة، وعلاقتها، لا تحضر.. كذلك نسمع عن اشتغال «مريوم» أم عبدالله كدلالة، تتجول بين الأحياء، لكن لا نستعيد علاقاتها وخبراتها داخل نسيج الرواية.. كذلك فإن والد وسمية، التاجر المتجول بين الموانىء البحرية المتعددة والأقطار، لا يحضر اطلاقا الى بنية الرواية.. وفي هذا الاختصار تركيز، ولكن قطع لعلاقات «الواقع» الواسعة، تمايزاته المختلفة، مستوياته المتعددة، أمكنته المتباينة، وتكثيف لمكان واحد وهو بيتي الحبيبين.. وعبر هذا المكان المحدد المكثف، نسترجع فسيفساء العالم القديم: سرير الماضي الذي أثمر الحب.. ان كل الاشياء العتيقة من بيوت، واحواش، وبرك، ودجاج، وطيور ولواوين، وطاسات، وخواتم، وسقوف الجندل، وقواقع، وعباءات الخ … كلها تستعاد عبر هذه الطاقة الحميمة لوعي معاصر، مغترب، يعيد تشكيل عالمه العتيق الجميل الذائب في تنور العصر.
وهذه الاستعادة لا تأتي قصدية، استعراضية، بل من النمو الجميل لعلاقة الحب الطفولية، التي تكبر فتبدأ الاصطدام بسلاسل الواقع.
وليس في النمو الطويل للعلاقة، تغلغل الى مستويات معقدة من الذات، أو البنى الاجتماعية بل عرض لعلاقة الحب البريئة، وهي تدخل حواجز الجنس والطبقات.
فما أن تكبر العلاقة، ويكبر الحبيبان، تبدأ الطقوس المكبلة للمرأة في الإعلان عن ذاتها، واسترجاع الفتاة من الزقاق والشاطىء واللعب، وتقوم بإسدال الستار على مفاتنها ووجهها وسحبها الى الاسوار.
كما تبدأ محاولات العاشق في اختراق الأسوار والعادات، عبر المغامرة الجريئة مرة، وعبر بضائع أمه الدلالة مرة أخرى.. ويكمن الحدث المركزي، في الرواية، في هذا الاختراق ودعوة وسمية الى اللقاء عند الفجر.
وبعد محاولات، ينجح اللقاء، ولكن تأتي مجموعة من الشرطة، لتفاجئ العاشقين، في صدفة غريبة تعكس مواتيف الرواية الرومانسية، فتذعر الفتاة الصغيرة، بعد سلسلة طويلة من المخاوف والترددات، فتلقي بنفسها في اليم، محاولة الغوص والاختفاء عن اعين الرقباء، اجراس الفضيحة.
تموت وسمية في هذا الحدث السريع الفاجع.. ويظل عبدالله طوال سنواته الكثيرة التالية يعيش على هذه الذكرى، لا يندمج في المدينة وتحولاتها النفطية السريعة، لا يحب امرأة اخرى، يتزوج أي امرأة تخطبها امه.. يلغى كل ذاته عند تلك اللحظة الطفولية البريئة الفاجعة.. بل هو يلغي ذاته، في الفصل الأخير، في الماء، وراء شبح وسمية.
تتضح آلية الرواية في تشكل ذه التعارضات المطلقة، بين البحر والمدينة، بين الماضي والحاضر بين عالم الغوص وعالم الرأسمالية المشوهة التابعة، بين والنضج، بين الاصالة والحداثة.
ان لحظة الطفولة المقامة فوق مجتمع غوص وبحر، لم تتفجر تناقضاته وصراعاته لوعي الروائية، حيث ثمة انسجام بين عناصره المختلفة الاجتماعية، ان هذه اللحظة هي الصفاء المفقود، هي الغابة العذراء التي لم تقتحمها بلدوزرات الحداثة، هي الريف البعيد عن علاقات المدينة النقودية هي الماضي الجميل المفقود..
حيث يحدث الخروج الأول على هذه الطفولة، فتظهر جدران بيت التاجر الكبير، وابنه فهد الشرس في محاربة الحب الوليد، تتشكل ملامح اغتيال الحب، واغتيال مشروع الانسجام بين عناصر الطبيعة والمجتمع.. ولو أن وسمية لم تمت، بذلك الشكل الميلودرامي السريع الفاجع، لماتت بشكل أخر.. ولكن آلية الرواية احتفظت لها بالموت، في البحر، في الغابة العذراء، في الريف غير المدنس بالتجارة.
في تلك السنوات فحسب، كانت امكانية الانسجام بين الاشياء والبشر، موجودة، أما بعدهها، فسوف تتفجر التناقضات، وتكتسح الراسمالية (انسانية) مجتمع البحر الساذج القديم…
اذن سيكون موت وسمية مخزوناً في اللاحق، ولكن كي تبقى تعويذة شعرية رومانسية، فلا بد أن تموت في السابق.
هكذا تنسحب الرواية من نثر الواقع الرأسمالي، نحو مناطق شعرية، ارتدادية، في الماضي، ولهذا نجد حياة عبدالله، في الحاضر، في العلاقات النقودية، شاحبة، انسحابية، لكون تواجده في هذه العلاقات، سوف يلغي امكانية الرواية، بآليتها الرومانسية الارتدادية الاجتماعية، وسوف ينمي عناصر تحليل الحاضر، وقطع العلاقة مع وسمية الطفلة الشفافة البريئة.
فكما كان المكان محدداً في الماضي، ببيتين وشاطىء، فكذلك كان المكان في الحاضر محدداً بعمل عبدالله الذي لا نعرف موقعه، ولا اصدقاءه، فكأن الرواية على مستويي الزمن، الماضي والحاضر، تكتفي ببقعة صغيرة، هي موقع تواجد البطل وعاطفته المتأججة.
ان الرواية تستعيد آليات الرواية الرومانسية الاجتماعية، فهناك البطل المتفرد، الاستثنائي العاطفة، وهناك المنطقة الطبيعية البكر العذراء، التي يلجأ إليها هذا البطل، صياغة لعالم انساني متفرد، حلمي، أو إنسحاباً اليه، وموتاً فيه، إذا تعذر صياغة هذا العالم الإنساني، في الحاضر، في الواقع.. لأجل أن تبقى العواطف الانسانية السامية، خارج الطبقات، والمصالح المتضادة، والتطورات النثرية للواقع.
وخلافاً لآلية وعي الرواية الرؤيوي، فإن آلية السرد تعتمد تضادات خاصة، صحيح أنها تجسد، في خاتمة المطاف، رؤية الوعي، ولكنها تفارقها، عبر هذا التحليل التفصيلي والواقعي للاشياء المفردة.. ان الكاتبة تصوغ عالماً يتراءى واقعياً محسوساً، غير الرصد المتأني لتطور العلاقة وحيثياتها، في المكان والزمان المحددين، بل وتنساق أحياناً نحو واقعية حرفية، تستعيد حتى المفردات الشعبية، بما يشكل أحياناً اقتراباً من الطبيعة.. ولكنها كذلك تصعد نحو ذرى شعرية تعبيرية، في قمم نمو العلاقات العاطفية وانكساراتها.
أن «وسمية..»، «تخرج»، «من البحر» ولا تغرق فيه» حيث انها تشكيلة انسانية رمزية، للنقاء المتعذر حدوثه في المدينة، والصاعد من البحر، فقط لا الطالع والنابت في المدينة الاغترابية الساحقة، لتتراءى وسمية حلماً ورمزاً للذين يستعيدون تماسك عالم البحر، شكلاً متجاوزاً لموت نثري كل يوم، في المدينة.
December 23, 2023
الرواية بين الإمارات والكويت (1 من 4) : كتب ــ عبدالله خليفة
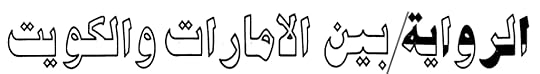
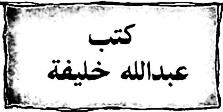
لم تظهر الرواية في الخليج العربي إلا في العقود الثلاثة الاخيرة من القرن العشرين.
وبشكل محدود وقليل، وقد سبق أن ظهرت روايات نادرة في لحظات متفرقة، متباعدة، مثل رواية «ملائكة الجبل الأخضر» . لعبدالله محمد الطائي وغيرها، إلا أن الظهور الأخير للرواية العربية في منطقة الخليج، كان الأكثر ديمومة وفنية.
ان هذا الظهور المتأخر، والنادر للرواية في الخليج، يعود إلى تأخر النهضة الاجتماعية في المنطقة، وبروزها بشكل خافت، في منتصف القرن، ثم انفجارها في العقود الاخيرة.
وحتى فن القصة القصيرة، الرديف الآخر لفن الرواية، ظهر متاخراً ومحدوداً، ومتقطعاً، ليبدأ تطوره السريع والعميق في ذات الفترة التي بدأت تتشكل فيها بذور الرواية.
إن ارتباط فن الرواية، بعمليات التطور العميقة الحديثة في البُنى الاجتماعية . قد صار أمرا مقررا ومعروفا، منذ أن قيل إن الرواية «ملحمة المجتمع البرجوازي» فمع تصاعد دور الطبقة المتوسطة، وقيامها بتحديث المجتمع، وتغيير بنيته الاقطاعية القديمة، واتجاهها لمركزة المجتمع المشتت، وخلخلة تركيبته المتخلفة وتحديثها، تبدأ الفنون الحديثة، وخاصة الرواية، في تركز أجزائها وبلورة كليتها العضوية، وقدراتها في استيعاب تطورات الواقع وتناقضاته.
وتحدث توجهات عدة في عملية استيعاب الواقع، تبعا للمواقف الاجتماعية المختلفة والرؤى الشخصية ومستويات تطور كل بلد على حدة، و تتضافر تأثيرات فنية مختلفة، عربية وعالمية، في رفد هذه العملية المعقدة .
ويبدو واقع الخليج العربي، بسيطا في تشكيل هذه العملية الاجتماعية الفنية، سواء من حيث حداثة النشاة الروائية، أو في قلة انتاجه في هذا النوع الإبداعي.
فقد بدأت المدن الخليجية مؤخراً، مثل الكويت، المنامة، دبي، ابوظبي، الشارقة، الدمام الخ .. في التحول الى مدن عصرية كبيرة، وراحت بُنى الدول الحديثة تتمركز. وتنمو قطاعاتها الاقتصادية، وتتشكل طبقات حديثة راحت تنتج اشكالاً متعددة من الآداب والفنون .
وكانت الكويت، والبحرين، مسرعتين في هذا التبلور الاجتماعي، ونمو الوعي الفني، نتيجة لبدء استخراج النفط فيهما مبكراً،وبسبب صغر حجم البلدين وتسارع نمو بنيتهما بصورة اكبر من الدول الأخرى، وتشكل طبقة متوسطة منذ العقود الأولى للقرن العشرين.
ثم لحقتهما دولة الإمارات في عملية التطور الاجتماعي، وبصورة سريعة، وشاملة، مما أدى إلى تنامي أشكال الوعي الفني المختلفة في المنطقة. وتواكبت مع هذه التطورات نهضة الانواع النثرية وخاصة القصة القصيرة والمسرحية. فنجد أن بدايات الحركة القصصية القصيرة تلاح منذ الخمسينات، ثم تتدفق في السبعينات، وتتجه في أغلبها الأعم ، إلى التقاط نماذج مطحونة من البيئة وواقع الحياة، وعبر لقطات مكثفة على ظاهرات التحول.
إن اللقطة الجزئية. والحدث الواحد ، والنموذج المسيطر، هي أساسيات القصة القصيرة، وهذا ما يقودها الى التركيز على الموقف الصغير، واللحظة المقطوعة بسياقات التحول الواسعة، وإشكالات المدن الحديثة العميقة، التي لم تعد فقرا ظاهرا أو مشكلات جزئية محدودة فقط .
كما أن الوعي الفني في الخليج، راح منذ مدة طويلة، يشكل المسرحية، وهى البناء الدرامي المطول، عارضاً مجموعة من النماذج والأحداث في توليفة فنية، تستهدف عرض مشكلات المجتمع البارزة.
إن هذا الوعي الفني نفسه هو الذي راح ينعطف بالقصة القصيرة، نحو القصة الطويلة، أو الرواية، في أعمال متناثرة، لكنها تعبر عن ذات الظاهرة التي يصادفها الوعي الفني في اسئلته المقلقة الحائرة عن التطور.
إن بطء تشكل الرواية في الخليج، وندرة اعدادها، يعبر عن هذا النمو البطيء للتطور، والاتساع الهائل للصحراء والبادية، وضآلة المدن في هذا الامتداد الضخم، وغياب فاعلية الطبقات والمؤسسات الحديثة . فنجد أن دولة ضخمة كالمملكة العربية السعودية لم تشهد إلا ثلاث روايات في سنوات متباعدة من القرن العشرين، ثم لم تظهر الرواية في العقود الثلاثة الاخيرة من النهضة المتسارعة والكبيرة فيها. وكما أوضحنا فقد كان عامل التطور الأكبر في الكويت والبحرين، من الأسباب المؤدية لهذا النهوض الروائي فيهما.
أن المدن البحرية الصغيرة، الكثيفة السكان، الواقعة على طريق تجاري دولي، وفي ظل تطور اقتصادي، وثقافي: متسارع ستشهد هي ميلاد ونمو الرواية. وسيكون لهذه النشأة المدينية بصماتها القوية على موضوعاتها واشكالها ومضامينها.
فهذه المدن البحرية التي كانت جزءا أساسياً من نسيج مجتمع الفوضى، ستبدأ هي، قبل غيرها، في الانفلات من شبكة العلاقات الاجتماعية القديمة وبالإحساس بصدمة التطور والحداثة، أي ازمة التحول من نمط من العلاقات إلى نمط آخر. وكان للنمط الاجتماعي، بعلاقاته الأبوية، ونموه في أحضان الطبيعة «البكر» واشكال علاقاته الجماعية التآلفية والحميمة، ذكرى جميلة واصداء في جانب من الوعي الفني. كما سيكون لهذه العلاقات القديمة ذكرى بغيضة، في جانب آخر من الوعي الفني، سيرى سيرورة علاقات الاستغلال بين مجتمع غوص قديم ذي علاقات متخلفة، ومجتمع رأسمالي غريب التكوين، وحاد الميلاد.
وكما نشأ مجتمع الخليج الحديث من وشائج المجتمع القديم، التي ظلت متشبثة بقوة، فيه، فإن الرواية ولدت من عوالم القصة القصيرة، دون أن تستطيع تماما، تكوين بنيتها المتبلورة.
فكل منتجي الرواية هم، اساسا، كتاب قصة قصيرة، راحوا يطوعون البناء القصصي القصير لعمل روائي موسع، كما فعل وليد الرجيب في «بدرية» حيث حشد عدة قصص قصيرة في عمله الأول، وكما تفعل ليلى العثمان ، في توسيع بنية القصة القصيرة وتمديدها لتشمل موضوعات عدة، في حين يظل المحور القصصي واحدا، والشخصيات قليلة، واللغة الفنية مكثفة وموجزة .
إن نمو الرواية من معطف القصة القصيرة، يدل بوضوح على بكارة النسيج الروائي الخليجي، وعدم وجود في خلفية فنية عميقة يستند عليها في تشكيلته المعاصرة . لهذا فإن معظم الروايات هي من النوع القصير، الذي لا يتجاوز المائة والخمسين صفحة، من القطع الصغير، إلا فيما ندر، ورغم ان روايتي علي ابوالريش: «الاعتراف»، و«الزهرة والسيف»، تتجاوزان هذا العدد، إلا أن بنيتهما الفنية تمتاز بالقصر، رغم الطول الظاهري لعدد الصفحات.
فروايتاه الأولى والثانية رغم اتساعهما الكمي، إلا أن العديد من المشاهد القصصية والحوارات التعليقية زائدة، وكان يمكن ضغط بنيتهما الى درجة كبيرة . راجع فصل (حول التقنية والأحداث).
ويمكن ملاحظة الطابع القصصي القصير المختصر، في رواية محمد حسن الحربي كذلك، حيث لا تتجاوز صفحاتها الخمس والثمانين صفحة. وهي تدور حول عدة شخصيات وأحداث، بصورة وامضة، سريعة، فلم تأخذ الشخصيات والأحداث العديدة، حقها من التشبع الفني. ويمكن ملاحظة سمة القصر والكثافة، في روايات خليجية أخرى لم تبحث هنا، كرواية امين صالح «أغنية أ . ص الأولى»، و«الجذوة» لمحمد عبد الملك وغيرهما.
إن سمة القصر والتكثيف ليست سمات شكلية بحته هنا، بل مرتبطة بالتشكيل الإبداعي. فهذا القصر يقود الى عدم تشبع التحليل الفني للواقع. فالشخصيات القليلة والأحداث الصغيرة، لا تقوم بمد شبكتها الواسعة في الحياة، واكتشاف تعدد مستوياتها وصراعاتها وعوالمها الخفية ووجودها النفسي والروحي، بل هي تركز على جوانب صغيرة، كما فعل علي أبوالريش في روايته الأولى، حين ركزت الرواية على واقع الشخصيات الفردي، وانقطع علاقاتها بما هو خارجها، وحين اتجهت الرواية الثانية الى تحليل المدنية المعاصرة، ومقارنتها بعالم البحر فإنها وقفت على ضفاف المدينة وعوالمها .
كما جاءت روايتا «وسمية تخرج من البحر»، و«المرأة والقطة» لليلى العثمان، مركزتين على حدث يعيش على ضفاف المدينة الخليجية المعاصرة. كان الحدث في الرواية الأولى مركزا على الاتجاه نحو، الحر، والغرق في عوالمه القديمة، الشفافة، التي غدت بديلا رومانسيا عن الواقع المعاصر. وكان الحدث في الرواية الثانية توغلاً في مستشفى أعصاب، عبر نموذج معاصر انكسر نتيجة سيطرة العلاقات الأبوية القديمة. فلم تكن العمة المسيطرة في الرواية، إلا البديل العنيف عن أب ضعيف. وهنا يسيطر موتيف الصراع بين الجدب والخصب، كموتيف تجريدي لا يأخذ لحمه ودمه، من نسيج العلاقات الاجتماعية الحية .
ورغم أن هذا الصراع بين الجدب والخصب، القديم والمعاصر، قد سيطر على رواية وليد الرجيب «بدرية» إلا أن الروائي هنا، أعاد تشكيل هذا الموتيف من عصارة الحياة الشعبية ومن مرارة الأشياء المتعددة المتناقضة، فقد قام باكتشاف بنية المدينة الخليجية، وصراعاتها الاجتماعية ، بين البحارة الذين تحولوا إلى عمال، والنواخذة والطواشين، الذين تحولوا إلى رأسماليين وموظفين كبار .
ومن هنا نجد هذه الحيوية التي تتسم بها رواية الرجيب، التى اتسعت مكاناً وزماناً، كسرت دائرة الانحصار في زاوية محدودة، وركضت شخصياتها بين البحر والمعمل والازقة والمدينة المتحولة النامية .
ان رواية وليد الرجيب تقدم صورة واسعة للمدينة، ونسيجها الداخلي، عبر شبكة صراع شخصية وطبقية، كما تصور المهن والعادات والاحتفالات القديمة، بصورة سريعة أيضا ، وكأن «بدرية»، تحاول أن تصف وتعبر عن كل التطور الحاصل في المجتمع الخليجي، عبر ثلاثين سنة، وفي حجم صغير (عدد صفحات الرواية 132 صفحة من القطع الصغير).
ولهذا فأن هذا الاتساع الكبير، وشمولية الرؤية، بين الماضي والحاضر، بين طبقات المجتمع المتناقضة، كان لا بد أن يكون له تأثيره على نوعية الشخصيات والأحداث، فقد غدت هذه منمطة ، تعبر عن العام الاجتماعي بدون الخاص الفردي، رغم محاولات المؤلف إعطاء لمحات شخصية متفردة. مثلما فعل تجاه شخصية بدرية التي صارت رمزا كاملاً لا شخصية حية متناقضة. وقد تمثل التنميط في أحداث الرواية، عبر هذا التناقض والصراع بين بؤرتي البنية الفنية، فهناك بؤرة للبناء الروائي، حيث القصة ذات الحدث الروائي غير القصير، المتسع . وهناك بؤرة التصوير التسجيلي والاحتفالي للحي الشعبي، التي حشدت فيها عدة قصص قصيرة .
وليست الرواية الاماراتية بعيدة عن مسار واشكالات الرواية الكويتية. فلقد نمت الرواية الاماراتية بخطى صاعدة ، ولكن محدودة ومتقطعة. فرواية «شاهندة»، المبكرة عكست سمات قديمة في الرواية العربية ككثرة المغامرات والتحولات المفاجئة والانقلابات الحديثة والشخصية، بحيث ان الرواية لم تستطع أن تصور شخصيتها المحورية، بحيث ان الرواية لم تستطع أن تصور شخصيتها المحورية، من جوانب عميقة، ولم تستطع أن تتابع شبكة الشخصيات العديدة التي ظهرت ثم اختفت، عبر تعاريج وتضاريس الأحداث الغريبة الكثيرة. كذلك فإن المكان بدا متغيراً بسرعة الأحداث، حتى اننا لم نلم بمكان ذى حضور روائي هام.
ولهذا فإن القرية البحرية المصورة – جنين المدينة الخليجية المعاصرة – سرعان ما تذوب أجوائها وتختفى شخصيتها، عبر هذا الطيران المتسارع للأحداث، وإذا كان علي محمد راشد يتابع هذه التقنية القديمة في الرواية الاماراتية والعربية، عبر سيطرة الاحداث السياسية العامة المتسارعة، وفي عدم التوغل داخل نسيج الشخصية والمكان والزمان، فإن روائيين إماراتيين آخرين يبدأون بتجاوز هذا المستوى الفنى.
لقد بدا علي ابوالريش قريباً من هذا المستوى في روايته الأولى، لكنه امتاز بخصائص فنية جديدة ملفتة للنظر، فقد تناغم لديه التحليل الاجتماعي والسيكولوجي للشخصية، عبر لغة سردية – حوارية واسعة – ومتخلخلة إلى كميات الشخصية والحدث.
ان «الاعتراف»، ذات النسيج الميلودرامي، والتي تحتوي على العديد من الخصائص رواية المغامرات والأحداث المفاجئة، قد امتلكت كذلك معماراً جيداً، عبر السيطرة على الحدث المركزي الثاني، لا الأول، وترابط الحدث والشخصيات، رغم تناقض بؤرتي الرواية، حيث كانت البؤرة الاولى تتركز حول انتقام صارم، والثانية حول زواجه وحبه وصداقاته، أن عدم السيطرة على هاتين البؤرتين وعدم اندماجهما معا في نسيج واحد متداخل، أدى إلى عدم وجود صراع ملتهب مفجر لنمو الحدث والشخصية.
لكن روايته الثانية شهدت تطوراً هاماً، حيث سيطرت فيها بؤرة واحدة، هي الصراع في ذات سلطان – البطل المحوري، بين البحر والمدينة، بين الأصالة والمعاصرة، بين الشرق والغرب.
لقد صار سلطان هو النموذج المركزي، الذي تدور حوله كافة جزيئات العمل وأحداثه وأمكنته، وعبرٌ هذا النموذج عن صراعات هامة في الحياة، رغم وقوف الشخصية، أيضا، على ضفاف المدينة، فنحن لا نجد إلا الصراع بين العمالة الأجنبية والمدينة العربية الخليجية، وكأن هذه المدينة تفتقد التناقضات الداخلية، التى تسربت منها العمالة الاجنبية.
لكن وجود بؤرة مركزية صراعية متوترة أدى الى تطور اللغة الروائية عند علي أبوالريش وتناغم السرد والوصف والحوار مع الحالات الداخلية للشخصية ومحور الرواية. رغم أن مساحات التشكيل السردية الوصفية – الحوارية تطول احياناً وتتكرر بلا وظيفة فنية.
وهذا ما يشابه في بعض جوانبه اسلوب علي محمد راشد في روايته التاريخية التسجيلية «ساحل الابطال»، التي تركز على عدم تناقضية المدينة الخليجية، ووحدة صفوفها، مما يشكل لوحة رومانسية خيالية، رغم الطابع الوطني والقومي المضيء لهذا التصور.
ان هذا التوجه الروائي، كما في المثالين السابقين، لا يتغلغل في صراعات المدينة الخليجية ذاتها، وهو يضعها دائما في مواجهة التناقض مع الاجانب، سواء كانوا مستعمرين قساة أو عمالاً فقراء.
لكن ثمة توجه آخر، في الرواية الاماراتية، يمثله محمد الحربي في روايته «أحداث مدينة على الشاطىء»، الذي يصور تناقضات المدينة ذاتها. فنحن نجد المدينة هنا كائنا اجتماعيا وتاريخيا ناميا، وليس شكلاً عمرانياً منجزاً ومادياً محضاً. فالروائي هنا يغوص عبر نماذجه الكثيرة، في هذه البلدة البحرية ــ البدوية المتحولة الى تجمع ضخم. وهو يصيغ عبر السرد الواسع هذه الشبكة من الشخصيات والأحداث.
إن بذور مدرسة فنية أولية تتضح من هذا العرض. فاغلب النماذج المدروسة هناك تتجه الى تصوير الواقع ونقده. ان عرض النماذج المأزومة في القصة القصيرة يقود الى البحث عن الشبكة الواسعة لتشكيل البشر . فليلى العثمان في تجربتها الروائية تقوم برصد نماذج مأزومة، في واقع تسيطر عليه تناقضات مجردة: القديم/ الحديث، البحر/ المدينة، التخلف/ التقدم. فعبدالله البحار القديم لا بلدته البحرية الجميلة الإنسانية، فيقرر أن ينتحر متحداً بنموذجه الجمالي القديم، وحبه. ان هذا الانسحاب الاحتجاجي لا يتوغل في تضاريس الواقع المعاصر، ولكنه يمثل ادانة رومانسية عنيفة ضده.
أما وليد الرجيب في «بدرية»، فإنه يتوغل في عروق الحياة، كاشفاً تناقضاتها الداخلية، وطابعها التاريخي المرحلي، وهنا تتضافر روح شعبية ساخرة واحتفالية، مع منهج تحليلي طبقي، يتعاونان في تشكيل رواية أكثر غوصاً في واقعيتها النقدية. ونلحظ عند علي أبوالريش ما نلحظه لدى ليلى العثمان، من تزاوج بين الواقعية والرومانسية، حيث يتجسد تناقض البحر/ المدينة، الماضي/ الحاضر، التراث/ المعاصرة، في ذات الروايتين «وسمية تخرج من البحر»، و«السيف والزهرة». ولكن علي أبوالريش يتوجه بصورة أكبر، لنشر الحياة، لتصوير الواقع بمظاهره البارزة، وكأنه يبدأ مشروعاً كبيراً لقراءة نقدية ودينية للمدينة المعاصرة.
يشابه محمد حسن الحربي وليد الرجيب في الكويت، في بحثه النقدي التاريخي للواقع، وكشفه لصراعاته الممتدة من الماضي الى الحاضر، عبر لغة هادئة وتشكيلية للعالم. وتبدو رؤيته متخلصة من هذا الذوبان في البحر والماضي، ومتجهة بصورة أكبر، لقراءة تأثير البر والبادية على تكوين المدينة، وهو يوسع الطابع البدوي ويقرأه بصورة مترافقة مع التحليل الاجتماعي النقدي للتطور .
ورغم هذا فلا تزال هذه الرواية الخليجية البكر على ضفاف التحليل العميق الموسع للواقع، لم تتغلغل بعد الى الطبقات التحتية الكثيفة له، وخاصة المستويين الروحي والنفسي، ولا تزال تمشي فوق تضاريسه الاقتصادية والاجتماعية المباشرة .
ونظرا لكل ما سبق، فليس لدينا في النماذج المدروسة، تقنيات ابداعية الجديدة. أى مبتكرة، فهي تتركز على الاستخدام الموسع للسرد، الذي يبدو مكثفا وامضا عند ليلى العثمان، واجتماعيا ومعتمدا على تقارير البحث الاجتماعي عند وليد الرجيب، وواسعاً ومندمجاً بوصف وحوار – بلا فواصل – لدى علي ابوالريش، وواسعاً مسيطراً لدى محمد حسن الحربي. وغالباً ما يكون الحوار والوصف في تبعية شبه مطلقة للسرد. كما أن الاستبطان والحوار الداخلي كبير لدى ليلى العثمان وعلى ابوالريش، حيث يغدو داخل الشخصية، أهم بكثير، من الظاهرات الخارجية والرصد الاجتماعي، في حين أن الحوار الداخلي لا يمثل شيئاً مهماً واساسياً في تقنية وليد الرجيب ومحمد الحربي، حيث يتركز البناء على الخارج، والتطور العام. ولم نجد في رواية «بدرية» إلا حواراً داخلياً وامضاً وصغيراً، في حين أن حوار محمد الحربي الداخلي بدأ مفاجئاً ومنقطعاً عن بنية الرواية .
ان رواية الخليج الحديثة ــ المبكرة، تبدأ خطواتها الاولى في فهم الواقع، وتشكيل بنية متضافرة، ولهذا فإنها لا تستطيع ان تسيطر على أدواتها الفنية تماماً، وهي تبدأ بتشكيل مفرداتها الاساسية اولاً كالسرد وتشكيل الشخصية وبناء المحور الواحد الأساسي للرواية، وتبقى مهمات جمالية اجتماعية كبيرة أمامها، للسيطرة على عالمها الفني.
يتبع 2 من 4 ...
الرواية بين الإمارات والكويت: كتب ــ عبدالله خليفة
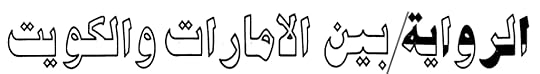
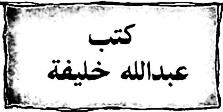
لم تظهر الرواية في الخليج العربي إلا في العقود الثلاثة الاخيرة من القرن العشرين.
وبشكل محدود وقليل، وقد سبق أن ظهرت روايات نادرة في لحظات متفرقة، متباعدة، مثل رواية «ملائكة الجبل الأخضر» . لعبدالله محمد الطائي وغيرها، إلا أن الظهور الأخير للرواية العربية في منطقة الخليج، كان الأكثر ديمومة وفنية.
ان هذا الظهور المتأخر، والنادر للرواية في الخليج، يعود إلى تأخر النهضة الاجتماعية في المنطقة، وبروزها بشكل خافت، في منتصف القرن، ثم انفجارها في العقود الاخيرة.
وحتى فن القصة القصيرة، الرديف الآخر لفن الرواية، ظهر متاخراً ومحدوداً، ومتقطعاً، ليبدأ تطوره السريع والعميق في ذات الفترة التي بدأت تتشكل فيها بذور الرواية.
إن ارتباط فن الرواية، بعمليات التطور العميقة الحديثة في البُنى الاجتماعية . قد صار أمرا مقررا ومعروفا، منذ أن قيل إن الرواية «ملحمة المجتمع البرجوازي» فمع تصاعد دور الطبقة المتوسطة، وقيامها بتحديث المجتمع، وتغيير بنيته الاقطاعية القديمة، واتجاهها لمركزة المجتمع المشتت، وخلخلة تركيبته المتخلفة وتحديثها، تبدأ الفنون الحديثة، وخاصة الرواية، في تركز أجزائها وبلورة كليتها العضوية، وقدراتها في استيعاب تطورات الواقع وتناقضاته.
وتحدث توجهات عدة في عملية استيعاب الواقع، تبعا للمواقف الاجتماعية المختلفة والرؤى الشخصية ومستويات تطور كل بلد على حدة، و تتضافر تأثيرات فنية مختلفة، عربية وعالمية، في رفد هذه العملية المعقدة .
ويبدو واقع الخليج العربي، بسيطا في تشكيل هذه العملية الاجتماعية الفنية، سواء من حيث حداثة النشاة الروائية، أو في قلة انتاجه في هذا النوع الإبداعي.
فقد بدأت المدن الخليجية مؤخراً، مثل الكويت، المنامة، دبي، ابوظبي، الشارقة، الدمام الخ .. في التحول الى مدن عصرية كبيرة، وراحت بُنى الدول الحديثة تتمركز. وتنمو قطاعاتها الاقتصادية، وتتشكل طبقات حديثة راحت تنتج اشكالاً متعددة من الآداب والفنون .
وكانت الكويت، والبحرين، مسرعتين في هذا التبلور الاجتماعي، ونمو الوعي الفني، نتيجة لبدء استخراج النفط فيهما مبكراً،وبسبب صغر حجم البلدين وتسارع نمو بنيتهما بصورة اكبر من الدول الأخرى، وتشكل طبقة متوسطة منذ العقود الأولى للقرن العشرين.
ثم لحقتهما دولة الإمارات في عملية التطور الاجتماعي، وبصورة سريعة، وشاملة، مما أدى إلى تنامي أشكال الوعي الفني المختلفة في المنطقة. وتواكبت مع هذه التطورات نهضة الانواع النثرية وخاصة القصة القصيرة والمسرحية. فنجد أن بدايات الحركة القصصية القصيرة تلاح منذ الخمسينات، ثم تتدفق في السبعينات، وتتجه في أغلبها الأعم ، إلى التقاط نماذج مطحونة من البيئة وواقع الحياة، وعبر لقطات مكثفة على ظاهرات التحول.
إن اللقطة الجزئية. والحدث الواحد ، والنموذج المسيطر، هي أساسيات القصة القصيرة، وهذا ما يقودها الى التركيز على الموقف الصغير، واللحظة المقطوعة بسياقات التحول الواسعة، وإشكالات المدن الحديثة العميقة، التي لم تعد فقرا ظاهرا أو مشكلات جزئية محدودة فقط .
كما أن الوعي الفني في الخليج، راح منذ مدة طويلة، يشكل المسرحية، وهى البناء الدرامي المطول، عارضاً مجموعة من النماذج والأحداث في توليفة فنية، تستهدف عرض مشكلات المجتمع البارزة.
إن هذا الوعي الفني نفسه هو الذي راح ينعطف بالقصة القصيرة، نحو القصة الطويلة، أو الرواية، في أعمال متناثرة، لكنها تعبر عن ذات الظاهرة التي يصادفها الوعي الفني في اسئلته المقلقة الحائرة عن التطور.
إن بطء تشكل الرواية في الخليج، وندرة اعدادها، يعبر عن هذا النمو البطيء للتطور، والاتساع الهائل للصحراء والبادية، وضآلة المدن في هذا الامتداد الضخم، وغياب فاعلية الطبقات والمؤسسات الحديثة . فنجد أن دولة ضخمة كالمملكة العربية السعودية لم تشهد إلا ثلاث روايات في سنوات متباعدة من القرن العشرين، ثم لم تظهر الرواية في العقود الثلاثة الاخيرة من النهضة المتسارعة والكبيرة فيها. وكما أوضحنا فقد كان عامل التطور الأكبر في الكويت والبحرين، من الأسباب المؤدية لهذا النهوض الروائي فيهما.
أن المدن البحرية الصغيرة، الكثيفة السكان، الواقعة على طريق تجاري دولي، وفي ظل تطور اقتصادي، وثقافي: متسارع ستشهد هي ميلاد ونمو الرواية. وسيكون لهذه النشأة المدينية بصماتها القوية على موضوعاتها واشكالها ومضامينها.
فهذه المدن البحرية التي كانت جزءا أساسياً من نسيج مجتمع الفوضى، ستبدأ هي، قبل غيرها، في الانفلات من شبكة العلاقات الاجتماعية القديمة وبالإحساس بصدمة التطور والحداثة، أي ازمة التحول من نمط من العلاقات إلى نمط آخر. وكان للنمط الاجتماعي، بعلاقاته الأبوية، ونموه في أحضان الطبيعة «البكر» واشكال علاقاته الجماعية التآلفية والحميمة، ذكرى جميلة واصداء في جانب من الوعي الفني. كما سيكون لهذه العلاقات القديمة ذكرى بغيضة، في جانب آخر من الوعي الفني، سيرى سيرورة علاقات الاستغلال بين مجتمع غوص قديم ذي علاقات متخلفة، ومجتمع رأسمالي غريب التكوين، وحاد الميلاد.
وكما نشأ مجتمع الخليج الحديث من وشائج المجتمع القديم، التي ظلت متشبثة بقوة، فيه، فإن الرواية ولدت من عوالم القصة القصيرة، دون أن تستطيع تماما، تكوين بنيتها المتبلورة.
فكل منتجي الرواية هم، اساسا، كتاب قصة قصيرة، راحوا يطوعون البناء القصصي القصير لعمل روائي موسع، كما فعل وليد الرجيب في «بدرية» حيث حشد عدة قصص قصيرة في عمله الأول، وكما تفعل ليلى العثمان ، في توسيع بنية القصة القصيرة وتمديدها لتشمل موضوعات عدة، في حين يظل المحور القصصي واحدا، والشخصيات قليلة، واللغة الفنية مكثفة وموجزة .
إن نمو الرواية من معطف القصة القصيرة، يدل بوضوح على بكارة النسيج الروائي الخليجي، وعدم وجود في خلفية فنية عميقة يستند عليها في تشكيلته المعاصرة . لهذا فإن معظم الروايات هي من النوع القصير، الذي لا يتجاوز المائة والخمسين صفحة، من القطع الصغير، إلا فيما ندر، ورغم ان روايتي علي ابوالريش: «الاعتراف»، و«الزهرة والسيف»، تتجاوزان هذا العدد، إلا أن بنيتهما الفنية تمتاز بالقصر، رغم الطول الظاهري لعدد الصفحات.
فروايتاه الأولى والثانية رغم اتساعهما الكمي، إلا أن العديد من المشاهد القصصية والحوارات التعليقية زائدة، وكان يمكن ضغط بنيتهما الى درجة كبيرة . راجع فصل (حول التقنية والأحداث).
ويمكن ملاحظة الطابع القصصي القصير المختصر، في رواية محمد حسن الحربي كذلك، حيث لا تتجاوز صفحاتها الخمس والثمانين صفحة. وهي تدور حول عدة شخصيات وأحداث، بصورة وامضة، سريعة، فلم تأخذ الشخصيات والأحداث العديدة، حقها من التشبع الفني. ويمكن ملاحظة سمة القصر والكثافة، في روايات خليجية أخرى لم تبحث هنا، كرواية امين صالح «أغنية أ . ص الأولى»، و«الجذوة» لمحمد عبد الملك وغيرهما.
إن سمة القصر والتكثيف ليست سمات شكلية بحته هنا، بل مرتبطة بالتشكيل الإبداعي. فهذا القصر يقود الى عدم تشبع التحليل الفني للواقع. فالشخصيات القليلة والأحداث الصغيرة، لا تقوم بمد شبكتها الواسعة في الحياة، واكتشاف تعدد مستوياتها وصراعاتها وعوالمها الخفية ووجودها النفسي والروحي، بل هي تركز على جوانب صغيرة، كما فعل علي أبوالريش في روايته الأولى، حين ركزت الرواية على واقع الشخصيات الفردي، وانقطع علاقاتها بما هو خارجها، وحين اتجهت الرواية الثانية الى تحليل المدنية المعاصرة، ومقارنتها بعالم البحر فإنها وقفت على ضفاف المدينة وعوالمها .
كما جاءت روايتا «وسمية تخرج من البحر»، و«المرأة والقطة» لليلى العثمان، مركزتين على حدث يعيش على ضفاف المدينة الخليجية المعاصرة. كان الحدث في الرواية الأولى مركزا على الاتجاه نحو، الحر، والغرق في عوالمه القديمة، الشفافة، التي غدت بديلا رومانسيا عن الواقع المعاصر. وكان الحدث في الرواية الثانية توغلاً في مستشفى أعصاب، عبر نموذج معاصر انكسر نتيجة سيطرة العلاقات الأبوية القديمة. فلم تكن العمة المسيطرة في الرواية، إلا البديل العنيف عن أب ضعيف. وهنا يسيطر موتيف الصراع بين الجدب والخصب، كموتيف تجريدي لا يأخذ لحمه ودمه، من نسيج العلاقات الاجتماعية الحية .
ورغم أن هذا الصراع بين الجدب والخصب، القديم والمعاصر، قد سيطر على رواية وليد الرجيب «بدرية» إلا أن الروائي هنا، أعاد تشكيل هذا الموتيف من عصارة الحياة الشعبية ومن مرارة الأشياء المتعددة المتناقضة، فقد قام باكتشاف بنية المدينة الخليجية، وصراعاتها الاجتماعية ، بين البحارة الذين تحولوا إلى عمال، والنواخذة والطواشين، الذين تحولوا إلى رأسماليين وموظفين كبار .
ومن هنا نجد هذه الحيوية التي تتسم بها رواية الرجيب، التى اتسعت مكاناً وزماناً، كسرت دائرة الانحصار في زاوية محدودة، وركضت شخصياتها بين البحر والمعمل والازقة والمدينة المتحولة النامية .
ان رواية وليد الرجيب تقدم صورة واسعة للمدينة، ونسيجها الداخلي، عبر شبكة صراع شخصية وطبقية، كما تصور المهن والعادات والاحتفالات القديمة، بصورة سريعة أيضا ، وكأن «بدرية»، تحاول أن تصف وتعبر عن كل التطور الحاصل في المجتمع الخليجي، عبر ثلاثين سنة، وفي حجم صغير (عدد صفحات الرواية 132 صفحة من القطع الصغير).
ولهذا فأن هذا الاتساع الكبير، وشمولية الرؤية، بين الماضي والحاضر، بين طبقات المجتمع المتناقضة، كان لا بد أن يكون له تأثيره على نوعية الشخصيات والأحداث، فقد غدت هذه منمطة ، تعبر عن العام الاجتماعي بدون الخاص الفردي، رغم محاولات المؤلف إعطاء لمحات شخصية متفردة. مثلما فعل تجاه شخصية بدرية التي صارت رمزا كاملاً لا شخصية حية متناقضة. وقد تمثل التنميط في أحداث الرواية، عبر هذا التناقض والصراع بين بؤرتي البنية الفنية، فهناك بؤرة للبناء الروائي، حيث القصة ذات الحدث الروائي غير القصير، المتسع . وهناك بؤرة التصوير التسجيلي والاحتفالي للحي الشعبي، التي حشدت فيها عدة قصص قصيرة .
وليست الرواية الاماراتية بعيدة عن مسار واشكالات الرواية الكويتية. فلقد نمت الرواية الاماراتية بخطى صاعدة ، ولكن محدودة ومتقطعة. فرواية «شاهندة»، المبكرة عكست سمات قديمة في الرواية العربية ككثرة المغامرات والتحولات المفاجئة والانقلابات الحديثة والشخصية، بحيث ان الرواية لم تستطع أن تصور شخصيتها المحورية، بحيث ان الرواية لم تستطع أن تصور شخصيتها المحورية، من جوانب عميقة، ولم تستطع أن تتابع شبكة الشخصيات العديدة التي ظهرت ثم اختفت، عبر تعاريج وتضاريس الأحداث الغريبة الكثيرة. كذلك فإن المكان بدا متغيراً بسرعة الأحداث، حتى اننا لم نلم بمكان ذى حضور روائي هام.
ولهذا فإن القرية البحرية المصورة – جنين المدينة الخليجية المعاصرة – سرعان ما تذوب أجوائها وتختفى شخصيتها، عبر هذا الطيران المتسارع للأحداث، وإذا كان علي محمد راشد يتابع هذه التقنية القديمة في الرواية الاماراتية والعربية، عبر سيطرة الاحداث السياسية العامة المتسارعة، وفي عدم التوغل داخل نسيج الشخصية والمكان والزمان، فإن روائيين إماراتيين آخرين يبدأون بتجاوز هذا المستوى الفنى.
لقد بدا علي ابوالريش قريباً من هذا المستوى في روايته الأولى، لكنه امتاز بخصائص فنية جديدة ملفتة للنظر، فقد تناغم لديه التحليل الاجتماعي والسيكولوجي للشخصية، عبر لغة سردية – حوارية واسعة – ومتخلخلة إلى كميات الشخصية والحدث.
ان «الاعتراف»، ذات النسيج الميلودرامي، والتي تحتوي على العديد من الخصائص رواية المغامرات والأحداث المفاجئة، قد امتلكت كذلك معماراً جيداً، عبر السيطرة على الحدث المركزي الثاني، لا الأول، وترابط الحدث والشخصيات، رغم تناقض بؤرتي الرواية، حيث كانت البؤرة الاولى تتركز حول انتقام صارم، والثانية حول زواجه وحبه وصداقاته، أن عدم السيطرة على هاتين البؤرتين وعدم اندماجهما معا في نسيج واحد متداخل، أدى إلى عدم وجود صراع ملتهب مفجر لنمو الحدث والشخصية.
لكن روايته الثانية شهدت تطوراً هاماً، حيث سيطرت فيها بؤرة واحدة، هي الصراع في ذات سلطان – البطل المحوري، بين البحر والمدينة، بين الأصالة والمعاصرة، بين الشرق والغرب.
لقد صار سلطان هو النموذج المركزي، الذي تدور حوله كافة جزيئات العمل وأحداثه وأمكنته، وعبرٌ هذا النموذج عن صراعات هامة في الحياة، رغم وقوف الشخصية، أيضا، على ضفاف المدينة، فنحن لا نجد إلا الصراع بين العمالة الأجنبية والمدينة العربية الخليجية، وكأن هذه المدينة تفتقد التناقضات الداخلية، التى تسربت منها العمالة الاجنبية.
لكن وجود بؤرة مركزية صراعية متوترة أدى الى تطور اللغة الروائية عند علي أبوالريش وتناغم السرد والوصف والحوار مع الحالات الداخلية للشخصية ومحور الرواية. رغم أن مساحات التشكيل السردية الوصفية – الحوارية تطول احياناً وتتكرر بلا وظيفة فنية.
وهذا ما يشابه في بعض جوانبه اسلوب علي محمد راشد في روايته التاريخية التسجيلية «ساحل الابطال»، التي تركز على عدم تناقضية المدينة الخليجية، ووحدة صفوفها، مما يشكل لوحة رومانسية خيالية، رغم الطابع الوطني والقومي المضيء لهذا التصور.
ان هذا التوجه الروائي، كما في المثالين السابقين، لا يتغلغل في صراعات المدينة الخليجية ذاتها، وهو يضعها دائما في مواجهة التناقض مع الاجانب، سواء كانوا مستعمرين قساة أو عمالاً فقراء.
لكن ثمة توجه آخر، في الرواية الاماراتية، يمثله محمد الحربي في روايته «أحداث مدينة على الشاطىء»، الذي يصور تناقضات المدينة ذاتها. فنحن نجد المدينة هنا كائنا اجتماعيا وتاريخيا ناميا، وليس شكلاً عمرانياً منجزاً ومادياً محضاً. فالروائي هنا يغوص عبر نماذجه الكثيرة، في هذه البلدة البحرية ــ البدوية المتحولة الى تجمع ضخم. وهو يصيغ عبر السرد الواسع هذه الشبكة من الشخصيات والأحداث.
إن بذور مدرسة فنية أولية تتضح من هذا العرض. فاغلب النماذج المدروسة هناك تتجه الى تصوير الواقع ونقده. ان عرض النماذج المأزومة في القصة القصيرة يقود الى البحث عن الشبكة الواسعة لتشكيل البشر . فليلى العثمان في تجربتها الروائية تقوم برصد نماذج مأزومة، في واقع تسيطر عليه تناقضات مجردة: القديم/ الحديث، البحر/ المدينة، التخلف/ التقدم. فعبدالله البحار القديم لا بلدته البحرية الجميلة الإنسانية، فيقرر أن ينتحر متحداً بنموذجه الجمالي القديم، وحبه. ان هذا الانسحاب الاحتجاجي لا يتوغل في تضاريس الواقع المعاصر، ولكنه يمثل ادانة رومانسية عنيفة ضده.
أما وليد الرجيب في «بدرية»، فإنه يتوغل في عروق الحياة، كاشفاً تناقضاتها الداخلية، وطابعها التاريخي المرحلي، وهنا تتضافر روح شعبية ساخرة واحتفالية، مع منهج تحليلي طبقي، يتعاونان في تشكيل رواية أكثر غوصاً في واقعيتها النقدية. ونلحظ عند علي أبوالريش ما نلحظه لدى ليلى العثمان، من تزاوج بين الواقعية والرومانسية، حيث يتجسد تناقض البحر/ المدينة، الماضي/ الحاضر، التراث/ المعاصرة، في ذات الروايتين «وسمية تخرج من البحر»، و«السيف والزهرة». ولكن علي أبوالريش يتوجه بصورة أكبر، لنشر الحياة، لتصوير الواقع بمظاهره البارزة، وكأنه يبدأ مشروعاً كبيراً لقراءة نقدية ودينية للمدينة المعاصرة.
يشابه محمد حسن الحربي وليد الرجيب في الكويت، في بحثه النقدي التاريخي للواقع، وكشفه لصراعاته الممتدة من الماضي الى الحاضر، عبر لغة هادئة وتشكيلية للعالم. وتبدو رؤيته متخلصة من هذا الذوبان في البحر والماضي، ومتجهة بصورة أكبر، لقراءة تأثير البر والبادية على تكوين المدينة، وهو يوسع الطابع البدوي ويقرأه بصورة مترافقة مع التحليل الاجتماعي النقدي للتطور .
ورغم هذا فلا تزال هذه الرواية الخليجية البكر على ضفاف التحليل العميق الموسع للواقع، لم تتغلغل بعد الى الطبقات التحتية الكثيفة له، وخاصة المستويين الروحي والنفسي، ولا تزال تمشي فوق تضاريسه الاقتصادية والاجتماعية المباشرة .
ونظرا لكل ما سبق، فليس لدينا في النماذج المدروسة، تقنيات ابداعية الجديدة. أى مبتكرة، فهي تتركز على الاستخدام الموسع للسرد، الذي يبدو مكثفا وامضا عند ليلى العثمان، واجتماعيا ومعتمدا على تقارير البحث الاجتماعي عند وليد الرجيب، وواسعاً ومندمجاً بوصف وحوار – بلا فواصل – لدى علي ابوالريش، وواسعاً مسيطراً لدى محمد حسن الحربي. وغالباً ما يكون الحوار والوصف في تبعية شبه مطلقة للسرد. كما أن الاستبطان والحوار الداخلي كبير لدى ليلى العثمان وعلى ابوالريش، حيث يغدو داخل الشخصية، أهم بكثير، من الظاهرات الخارجية والرصد الاجتماعي، في حين أن الحوار الداخلي لا يمثل شيئاً مهماً واساسياً في تقنية وليد الرجيب ومحمد الحربي، حيث يتركز البناء على الخارج، والتطور العام. ولم نجد في رواية «بدرية» إلا حواراً داخلياً وامضاً وصغيراً، في حين أن حوار محمد الحربي الداخلي بدأ مفاجئاً ومنقطعاً عن بنية الرواية .
ان رواية الخليج الحديثة ــ المبكرة، تبدأ خطواتها الاولى في فهم الواقع، وتشكيل بنية متضافرة، ولهذا فإنها لا تستطيع ان تسيطر على أدواتها الفنية تماماً، وهي تبدأ بتشكيل مفرداتها الاساسية اولاً كالسرد وتشكيل الشخصية وبناء المحور الواحد الأساسي للرواية، وتبقى مهمات جمالية اجتماعية كبيرة أمامها، للسيطرة على عالمها الفني.
يتبع…
December 20, 2023
رواية مريم لا تعرف الحداد: ملاحظات وانطباعات
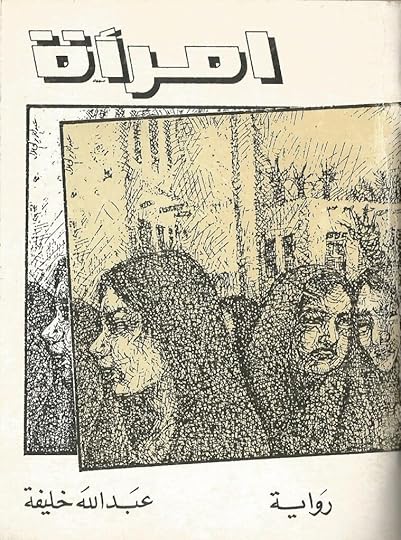
بقلم القارئ علي عيسى
الكاتب والروائي عبدالله خليفة كاتب قدير معروف وهو احد اقطاب القصة القصيرة في البحرين؟ وكان هذا الكاتب المعروف في قصصه السابقة يعني بالدرجة الاولى بالإنسان؟ فالإنسان يحظى عنده بالمرتبة الاولى من الاهتمام.
وفي هذه المرة طلع علينا كاتبنا برواية (مريم لا تعرف الحداد) التي كرسها لخدمة الإنسان وإبراز ما يعانيه ويعيشه من حياة وظروف سواء كان هذا الإنسان من المترفين أو كان من البسطاء الذين يكافحون من أجل لقمة العيش وغد أفضل .
في هذه الرواية يتمثل كما هو واقع الحياة، جانبا الخير والشر الضدان اللذان لا يلتقيان إلا في حالة مواجهة مستمرة وجها لوجه. عالم الزيف والترف والجبروت يمثل جانب الشر في هذه المعادلة الحياتية، بينما عالم البساطة والعفوية والطهر يمثل جانب الخير والعدالة والكرامة الإنسانية .
أحداث الرواية تدور في قرية صغيرة من قرى البحرين وهي قرية فلاحية لذلك تسمع فيها اصوات مكبرات الصوت التي تصدح بتلاوة القرآن وكما يقول الكاتب (أصوات الميكروفونات الباكية) ص ،18 ويدل ذلك انها تخرج من المآتم التي لا تكف عن البكاء في الليل والنهار .
على أحد جوانب القرية يقبع القصر الذي يمثل عالم الزيف والشر. وهو على مقربة من القرية إلا أن الكاتب وصفه بوعي كامل يخدم الجو العام للرواية بأنه بعيد عن البيوت . بيوت الأهالي الفقراء البسطاء الذين يمثلون جانب الخير. وذلك أن الكاتب يريد أن يوحي لقارئه بأن الشر حتى لو اقترب جغرافيا من الخير إلا ان هناك فاصلا يفصله وذلك ما يميزه عنه .
الحدث العام للرواية يقول ان هناك امرأة تدعى (مريم) وقد انجبت ابنا اسمه حسن . هذا الابن ربته هي بعرق جبينها لبعد والده عنه في بلاد الغربة، وكان هذا الولد بمثابة الامل المرتجى من هذه الحياة لكلا الوالدين الأب والأم ؟
ولكن سرعان ما رأت عين الشر هذا الأمل يكبر فعز عليها أن تتركه ينمو ويعمر قلب ونفس الأبوين فاغتالته وأي اغتيال؟ إنه تحويل هذا الامل إلى كتلة معجونة من اللحم الناعم وكلمة الناعم هنا إمعان في إبراز نضارة وخضرة الامل النامي الذي اغتيل غدراً . ثم تحويله الى كتلة معجونة، يتحول بعدها الى سراب يدفن في التراب فيكون تراباً . ومنذ هذه اللحظة يكون الصراع على أشده بين الخير الذي يريد أن يعبر عن نفسه ويريد أن يقول للناس لا بد ان اكون ويعرف الكل ان الحياة يجب ان تكون لي لا لغيري من الذين يعيشون على هامش الحياة!
ولكن الشر يقول أنا أقوى منك ولا بد أن أسود انا فالبقاء للأقوى لا للأصلح وافعل ما شئت، إن استطعت أن تفعل شيئاً وها أنا ذا.
وفي النهاية لا بد أن يكون الأمر كما هو في الواقع مع شيء من التجاوز احياناً أي ان ينتصر الخير على الشر .
ولكن في هذه الرواية انتصار الخير على الشر مختلف قليلاً؟ فالنصر عبارة عن رفض الخير للعروض المغرية التي عرضها جانب الشر ولكن الشر انتصر وذلك بتقييد الخير وتضييق الخناق عليه فهو لم يفعل شيئاً سوى ان أنتظر لكي يأتي مولود جديد ينجبه الخير نفسه ليبدأ المواجهة من جديد وذلك المولود هو النطفة الثانية التي كبرت من بطن الأم (مريم) فيكون الانتصار هنا هو استمرارية الصراع الذي اراد الشر أن يوقفه ان لم يقض عليه نهائياً.
ولكنه حتى في حالة ايقافه فالنصر هنا مهزوز وهش إذ أن الخير قد انجب من سيواصل هذا الصراع العنيف من جديد . وهذا توفيق وإجادة وفق إليها الكاتب فالقصاصون يجعلون النصر واقعاً حتمياً يبرز على صورة نهائية وينتهي بعدها الصراع. ولكن نظرة كاتبنا عميقة للحياة ولواقع الصراع الذي نبع حتماً من مخبرة شخصية ثرية تجعل الصراع مستمراً الى ما لا نهاية ؟ وكما اتصور فإنه حينما يجيء المولود الجديد فانه سيكبر ويصارع وينجب لكي يواصل الخلف الصراع وهذا هو النصر الجديد المختلف .
والكاتب في هذه الرواية استخدم في إبراز المواقف أسلوبا جميلاً يوظف فيه الطبيعة لخدمة كل لحظة من لحظات الموقف لكل شخصية على حده وكل هذه اللحظات والمواقف تتبلور وتتجمع لإبراز الجو العام للرواية.
فحينما تكون الأم (مريم) في حالة اكتئاب وحزن فإن الطبيعة تتعاضد معها وتكفهر محاولة تعزيتها ؟ فالطيور تصمت عن الغناء بل وتهجر أشجارها؟
والأشجار تصبع كالأشباح والنخيل مقطوع الرؤوس؟ وكل ما في الكون في حالة من السكون العميق. وبالأصح في حالة بكاء مستمر على روح الفقيد الصغير لب قلب الأم .
وحينما يتكلم عن صاحبه القصر التي تمثل الشر ويعرض لملذاتها وحياتها يصور لنا الكاتب جوانب مختلفة منها، فإذا كانت في حالة انشراح كانت الطبيعة كلها تنطق بذلك؟ وإذا كانت في حالة ملل أو سأم كانت الطبيعة جاهزة لإبراز هذه الحالة. وتوظيف الطبيعة لخدمة المواقف المختلفة شيء جميل جدا يوحي للقراء أن هذا الموقف هو موقف الكون كله لا موقف الشخص وحده؟ فالإنسان هو ابن الكون والكون هو المسير الأساسي لخطوات هذا الشخص وبالتالي فإن
التلازم بينهما يتناسب طرديا مع كل متغير يحدث لكل منهما .. فما يحدث للكون أو فيه يؤثر على الشخص وما يحدث للشخص يؤثر في الكون.
وفي هذه الرواية تبرز صورة المرأة الأم التي تمثل الخير – تبرز ايجابية قوية، وشخصيتها تنمو من بداية الرواية الى نهايتها حينما تكون هذه الأم هي الأرض الخصبة التي تنبت الامل الجديد الذي سيقف ويصارع الشر من جديد وايجابيتها تكمن في صراعها وعدم توانيها عن القيام بأعباء الصراع ورفضها لكل المغريات التي قد تدفع ضعفاء النفوس للركون الى الراحة وتفضيل لذة عابرة هي لذة المال على المواجهة من أجل غد أفضل بل وحياة أتية افضل ان لم تستطع القضاء على الشر فهي لا تهادنه وهذه المواجهة تجلب اللذة التي قد تكون خفية الى نفس المجاهد الذي يقارع الظلم والتسلط والزيف.
ولكننا نرى بالمقابل شخصية زوج هذه المرأة (عباس) فهو وإن كان في اعماقه خيراً ويحب الخير إلا أن اخطاءه جعلته ضعيفاً وقابلاً للانحناء إن لم يكن للكسر؟ فقد أفصح عن أسماء اصدقائه عندما اجبر على ذلك؟ وقبل المال في النهاية نتيجة للخطيئة الأولى التي جعلته يستمرئ الخطيئة من جديد. ولكن جانب الخير فيه باق، فقد ندم على افشائه لأسماء رفاقه وهذا يدل على نوع معدنه .. إلا أن ظروف الحياة القاسية التي جعلته ينهار في معدنه أول مرة جعلت معدنه قابلا للصدأ ولو قليلاً .. وهذا هو الذي للقبول بالمال وتناسى الولد القتيل.. مما جعله تافهاً في نظر زوجته التي عرفته جيداً وعرفت ان معدنه قابل للتأثر بالعوامل الشديدة إن لم يكن قابلا للتأثر بالعوامل الأقل شدة؛ وكانت نتيجة ذلك الصدأ الذى غطى هذا المعدن ببيعه لولده مقابل مال يتناقص كل لحظة إلى ان يصير صفرا أو يضيع المال ويضيع الشرف.
ومما يلاحظ أيضاً على هذه الرواية ان الكاتب استعان بفكرة دينية تقول بالمهدي المنتظر الذي يخرج في آخر الزمان ليملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجورا. فتسمية الرجل الصالح ذي اللحية الكثة باسم مهدي ليس عبثاً ولكن هذه التسمية غلفها الكاتب بحنكة حتى لا تبدو فكرة جاهزة استعملها كما هي. فقال بأن مهدي هذا هو الذي يتنبأ بالمولود او بالأصح بالقادم الجديد الذي يواصل عملية الصراع بين الخير والشر وتكون النتيجة الحتمية الكامنة في نفس الكاتب هي انتصار القادم الجديد (المهدي) أي الخير على الباقي المستمر أي الشر .. وقد وفق الكاتب في هذا أيضاً .
ويلاحظ كذلك بعد الانتهاء من قراءة الرواية أن الكاتب مسح الرواية »وأحداثها بفكرة تاريخية دينية وردت في الكتب السماوية ومنها القرآن الكريم، وهي قصة مريم بنت عمران التي جاءها المخاض الى جذع النخلة، وكذلك هنا في الرواية فاسم الام (مريم) وفي النهاية كما يقول الكاتب في ص 65، «تقترب من النخلة تتسلقها، ترتقي إلى قمتها» ولكنها وضعت المولود الجديد على الأرض طبعاً.
وليس من العبث أن يربط الكاتب بين الأم والنخلة في هذه الرواية، فمريم في الرواية قروية تعيش وتعمل بعد رحيل زوجها في الزراعة كأول عمل تقوم به ضمن الأعمال الأخرى التي اضطرت للقيام بها. إذن إرتباط مريم في الرواية بالنخلة له ما يبرره ومن هنا نشم رائحة الامتزاج بين القصتين ولجوء كلا المريمين، ان صح التعبير، الى النخلة
لكي تضع بشراً سوياً، وهذا لفظ قرآني استخدمه الكاتب. على أن هذا الاستخدام في الربط بين القصتين جاء من غير أن يحس القارئ العادي به .
ومما يلاحظ أيضاً استخدام اسم النمر يمثل الشر المتجسد في عالم البشر المزيفين ومطالبة مهدي للرجل الصالح الذي كان قد تنبأ بالمولود الجديد وقال انه سيأخذ ثأر الحسين وهو هنا رمز لدم كل الشهداء الذين يموتون في سبيل الحق مطالبة هذا الرجل الصالح للأم بأن لا تقتل الامل المتكون في احشائها حينما قال لها : «لا..لا.. لن اسمح لك.. أتعرفين من الطالع في احشائك، انه فتانا الموعود والطهر الذي ننتظره، هكذا قالت الرؤيا» إذن فتانا الموعود هو المهدي المنتظر.
ولكن الكاتب يجعل هذا المنتظر حينما ينزل الى الدنيا يسمى باسم علي، وعلي هو المطالب بالحق المقارع للظلم والشر . وتسمية المولود بعلي على عكس اسم المهدى المنتظر الذي اسمه (محمد) يدل على ان الكاتب اراد ان يستخدم الفكرة السائدة بأسلوب جديد؛ تتبدل فيه الأسماء الأماكن والصور ولكن يبقى الهدف والمعنى والغاية واحدة في الواقع، كما يؤمن به من يعتقدون ذلك وفي الرواية ايضاً. والرواية كما قلت جيدة واستطاعت بأسلوب قصصي رائع ابراز ما يريد الكاتب إبرازه إلا أن هناك بعض الملاحظات التي أتمنى ان يوضحها الكاتب وهي كما أرى ضرورية.
فالكاتب عبدالله خليفة كاتب عارف بالنفس البشرية ويعرف أنها لا تكون دائماً في الاتجاه الصحيح، فيتناوبها الأمن والخوف، الاقدام والاحجام والإصرار والانهيار والتراجع، ويتضح ذلك في عرضه لشخصية (مريم) التي هي قوية بطبعها وتمثل الخير والجمال والبساطة والعدل ولكنها بشر تضعف أمام الرياح والعواصف، فلذلك اهتزت في لحظة ما ولكنها تعاود حالتها الطبيعية المعروفة بها.
كذلك جعل الكاتب كل من يعيش في العصر يمثلون الشر والتفاهة والزيف من صاحبة القصر وزوجها الى ابسط خادم عندهم على تفاوت بينهم في تأصل أو وضوح الشر عليهم، وبالمقابل يجعل اهل القرية يمثلون الخير بالرغم من وجود بعض الطبائع المسترذلة عند بعضهم وبعض النقص، وهو ما لا تخلو منه نفس بشرية أو أمة من الأمم، فالبشر يصيبون ويخطئون ولكن السمة العامة واضحة .
واخيراً نقول ان كاتبنا وفق الى درجة ممتازة في إبراز ما يريد إبرازه، وهو من أعظم وأكفأ القصاصين عندنا؛ ومقدرته على التصوير في كل مؤلفاته بالغة الروعة وهو متمكن من لغته ومن صوره ولا نملك في النهاية إلا أن نحييه ونشد على يديه وتهنئه ونهنئ أنفسنا بكتاباته التي تهتم بالإنسان أينما كان؟ ونكبر فيه ابن المدينة الذي يصف القرية ويجعل البساطة القروية حاملة لكل معنى خير كالعدل والطيب والحب والخصب والاعتزاز بالكرامة، وكل ذلك تجسد في (مريم) بطلة الرواية. فتحية مرة أخرى .
مبارك الخاطر: الباحث الأمين المسؤول عن بقاء الضوء في الماضي
كتب : عبدالله خليفة
رجل غير جامعي يلعب دور جامعة!
منذ عقود غير بعيدة كان هذا الرجل البسيط المتواضع «مبارك الخاطر»، موظفا شبه مجهول في إدارة المحاكم، يدخل ويخرج حاملا أوراقه ومستنداته التاريخية، دون أن يحفل به أحد لم يذهب الى الجامعة ، واعتمد في ثقافته، على تعلمه واجتهاده الشخصي؛ واكب على المعرفة، وتعمق في ميدان ولعه الخاص. التاريخ البحريني ..
قبله، لم يكن ثمة تاريخ، كان الماضي قطعة سوداء من النسيان وفقدان الذاكرة، كان التلميذ البحريني في المدارس لا يعرف «أحمد الفاتح» أو «الزائد» أو «القرامطة»، كان يعرف فتوحات الاسكندر الاكبر، وكيف قتل يوليوس قيصر.. لكن تاريخ بلده، ومنطقته، أشبه باللغز الذي يطرحه ابوالهول..
وقد انطلق مبارك الخاطر في هذه المنطقة المعتمة الوعرة، اختار ميدان التاريخ؛ الميدان الاحفل بالألغام السياسية والفكرية، وبفقدان المواد والحيثيات والوثائق .
وكان الخاطر على صلة عائلية بأحد البارزين في عملية النهضة الخليجية المعاصرة، وهو عبدالله الزائد. فهذا الرجل هو صاحب علامات فارقة في تاريخ البحرين المعاصر فهو مؤسس لرموز تنويرية ساطعة: النادي الأدبي – سينما البحرين – جريدة البحرين ..
وقد دفعته صلة شخصية الى الاهتمام بهذا الرائد. وفي عملية بحثه ورصده لحياة الزائد، تلمّس خطوط التطور الأولى للبلد، فلم تكن حياة الزائد معزولة عن الأحداث والصراعات والتطورات. التي بدت غير واضحة وجلية؛ لمبارك الخاطر نفسه حينذاك، فقد أمسك حياة هذا المصلح الاجتماعي باعتباره شخصا طيبا وعظيما، وأراد أن يغرس ثمار النهضة والحضارة الجديدة في ربوع وطنه، ومن هنا حاول أن يبرز دوره في تأسيس النادي الأدبي وعلاقاته الشخصية مع الشيخ ابراهيم الخليفة وغيره من مؤسسي حركة النهضة في البحرين إبان الثلث الأول من القرن العشرين.
لقد بدت حياة الزائد في كتابه وكأنها حركة شخص يسعى لتأسيس ناد أدبي ودار سينما وخلق جريدة، ومن هنا حاول ان يدافع عن شخصه، من التهم التي «الصقت» به، الكتاب تحول هنا الى ترجمة لفرد، ودفاع شخصي عن الرجل المتنور .
كان هذا الكتاب الأول بكراً في الدرب الطويل؛ إنه افتتاحية البحث التاريخي الموسع الذي سوف يطل بعد سنوات. ولكن في هذه الافتتاحية، نرى الخصائص التي ستظل ملازمة للمنهج البحثي ــ التاريخي ــ الذى اختطه الخاطر لنفسه.
فهو بحث يتركز حول «شخصية»، هامة لعبت دوراً ايجابياً وتنويرياً في وقتها، ودفعت الحياة الفكرية دفعة قوية الى الامام.
والحيثيات التي ستكشف دور هذه الشخصية تعتمد اعتماداً رئيسياً على «الوثائق» المتوفرة، كرسالة أرسلها الزائد إلى الصحف المصرية، أو قصيدة منشورة، أو رسائل إخوانية، أو أعمال ملموسة محددة .
من هذه الوقائع سوف ينطلق الخاطر لتجلية أفعال «بطله» التاريخي؛ مراوحاً بين ظروف وقته الصعبة، وبدائية الامكانيات وندرة الجهود الخلاقة، وبين سطوع أعماله وجرأة أفعاله وأهميتها..
ولن يغوص الخاطر بعيداً في علاقات هذه الشخصية بالظروف الاجتماعية والفكرية والسياسية، وعلاقات هذه البنية الاجتماعية المحلية بالعالم الخارجي وتياراته وصراعاته، بل سوف يستل خيطاً دقيقاً ومهماً، هو دور البطل في مجتمعه، وأثره على معاصريه ..
وهو، في بحثه الأمين الصادق، سوف يتابع الشخصية في ماضيها وحاضرها. فهي ليست شخصية خارقة، بل ابنة ظروف معينة، وأهم هذه الظروف دوماً، لدى الخاطر، هو دور الأساتذة الأوائل والرواد السابقين .. فكان التاريخ هو تاريخ النابهين والمثقفين والمتنورين. فهم اداة الخصب والتغيير في الحياة .
لقد بدت وكأنها «صدفة». ان الخاطر قد بدأ بالزائد، ولكنه دافع الاخلاص والتقدير للشخصية النابهة السابقة . وهو الذي حرك عجلة البحث في حيوات الشخصيات الأخرى. فقد كان الزائد هو شخصية تالية، جاءت، في التاريخ، بعد قاسم المهزع، وناصر الخيري. لكن الكتابة عن الزائد فجرت البحث عن بقية أجزاء السلسلة .
إن هذا الترتيب، يؤكد، عفوية مخطط البحث في البداية، ثم اتجاهه إلى البرمجة والمنهجية المنظمة، فيما بعد.
وقد جاء كتابا «قاسم المهزع» و«ناصر الخيري»، وكأنهما متناقضان، ومرتبكان، في مادتهما، فالشخصيتان كانتا على طرفي نقيض تماماً، فناصر الخيري من المتنورين؛ الذين اتجهوا الى طرح أسئلة ليبرالية في عصر رهيب التخلف، في حين كان قاسم المهزع، من قضاة الشرع والمتحمسين في محاربة التحرر الليبرالي والأشكال الجينية للتنوير حينذاك، والتي يسمها «بدعا».
فكيف استطاع الخاطر أن يكتب عنهما الاثنين، بحرارة، ويدافع عنهما كليهما؟
في كتابه عن «قاسم المهزع». قفز الخاطر قفزة كبيرة في ميدان البحث التاريخي ، وهو هنا لم يأخذ الشخصية المحورية كشخصية متفردة، خارج ظروف الزمان والمكان، بل رسم لوحة عامة، برزت فيها حياة القاضي كجزء من عملية صراعية واسعة النطاق.
لكن هنا أيضا وصف هذه الشخصية ودافع عن دورها «السلفي»، في مواجهة العصرنة الزاحفة، وكانت مسيرة العصرنة – في ذلك الحين – متوافقة مع التدخل الأجنبي. فبدا كأن الظاهرتين من فعل فاعل واحد، ولهذا كانت مواقف قاسم المهزع المتجهة للتصدي للظاهرتين، معا مبررة في رأي الباحث.
ورغم هذا الطابع الضيق، وسيطرة «الايدلوجي» على «العلمي»، فإن الخاطر، في هذا الكتاب، يندفع خطوة جريئة، عبر ربط دور الحركة الفكرية والسياسية، بالبيئة الاجتماعية ككل، ويرى في عجز المصلحين حينذاك نقصا في روابطهم مع الناس، وعدم رؤيتهم للجوانب المتناقضة لفعل الإصلاح البريطاني وقتذاك.
ولكن يأتي في كتاب «ناصر الخيري». ليدافع عن شخصية تقف في منحى آخر، هو المنحى الليبرالي، الذي تعسف القاضي قاسم المهزع في التصدي له ؛ حتى وصل به الأمر إلى التهديد بجدع انف ناصر الخيري، إذا واصل اسئلته المثيرة في بداية القرن العشرين.
هنا نجد التبحر والتوسع الذي قام به الباحث في عالم القاضي المهزع، لم يواصله في عالم ناصر الخيري، ولعل محدودية المواد المقدمة عن الخيري، وعدم وجود انشطة واسعة له، بخلاف المهزع، هي التي جعلت توغله محدودا، مقتصرا على التعليق حول أسئلته المقدمة إلى جريدة «المنار» واجوبة المنار عليها، ثم تعليق آخر حول احدى رسائله، وحول بحثه الضائع؛ عن تاريخ البحرين، الذي لم ير النور.
ولكن هذا يبين كذلك عدم التوسع في رؤية تنويرية ناصر الخيرى المبتورة، من جراء التعسف السابق ذكره وأجواء التخلف الرهيبة حينذاك.
وهنا يبدو هذا الجمع المتردد بين السلفية والليبرالية، أو قل هي السلفية المطعمة بمشاعر ديمقراطية وانفتاحية، متجها لإبراز النهج السلفي التقليدي عن «القاضي الرئيس» وعدم الحماس للوعي الليبرالي النهضوي، كما اضمحل في سيرة الموظف المترجم «ناصر الخيري». في حين كانت سيرة الزائد تضخيماً للطابع الليبرالي المنفتح الذي وصل الى حدود الذوبان فـ«الغرب».
هناك إذن رؤية سلفية – ليبرالية توجه الخاطر في تحليله للشخصيات «النهضوية»، فهي تحافظ على المقومات العربية الاسلامية، كما هي مفهومة لدى التيار السلفي المتفتح، عبر تنقيحها وتشذيبها بمعطيات الحضارة الغربية المعاصرة «الإيجابية»، وإذا كان الخاطر لم يصغ، فلسفيا، مثل هذه الرؤية فإننا نلمح بعض عناصرها من خلال البحوث التطبيقية، أو لعل هذه الرؤية راحت تتشكل أثناء التنقيب في المادة التاريخية، وتبدو هذه القلقلة والترددات بين السلفية والليبرالية، ليست خاصية للخاطر وحده، بطبيعة الحال فهي سمة أجيال كثيرة في الثقافة العربية.
وقد واصل الخاطر بحوثه وتنقيباته التاريخية، بجهد فردي دؤوب، فاستطاع ان يجهز كتابات للمثقفين البحرينيين في الثلث الأول من هذا القرن، ويتابع تطور المسرحية التاريخية كما تشكلت عند العريض وفي المسرح المدرسي ويكتب بحوثا جزئية حول ظهور المطابع في البحرين الخ …
وهذه الجهود كلها تؤكد استمرار الباحث في تسليط الضوء على التاريخ الذي لم يعد مجهولا، كليا، بفضل هذا الجهد الطليعي ..
المؤرخ البحريني مبارك الخاطر يضيء تاريخ الكويت الثقافي
المسيرة الصعبة للكتب والمكتبات والثقافة في الخليج
يمثل مبارك الخاطر المؤرخ الأكثر دأبا ونشاطا في إضاءة زوايا التاريخ الثقافي المعاصر المعتمة، في البحرين ومنطقة الخليج عموما، لقد كثرت اصداراته في هذا المجال وتركزت على تسليط الأنوار على الحركة الثقافية والاجتماعية البحرينية في النصف الأول من القرن العشرين، حيث مثلت «الثقافة» أحد أهم الأشكال والتجليات لنمو الوعي الوطني بعناصره المختلفة، وقد عبرت كتبه «القاضي الرئيس قاسم المهزع»، و«الكتابات الاولى الحديثة لمثقفي البحرين»، و«نابغة البحرين عبدالله الزائد»، وغيرها عن هذا الرصد التحليلي الطويل، بحيث غدا تاريخ البحرين الاجتماعي الثقافي المجهول بشكل كبير، يتجه نحو الوضوح والتبلور.
وهو في كتابه الحالي الذي نستعرضه هنا (المؤسسات الثقافية الاولى في الكويت)، والصادر عن دار قرطاس للنشر سنة 1997، يتوجه نحو حقل جديد من حقول البحث التاريخي، وهو رصد بدايات الحركة الاجتماعية والثقافية في الكويت.
إن منهج مبارك الخاطر يتمثل في التركيز على بؤر بحثية معينة وكشفها عبر موادها المتوافرة، وغالبا ما تكون هذه المواد فقرات من رسائل وصفحات من جرائد وكتب وشهادات من رجال عاشوا في تلك الفترة المبحوثة.
ومبارك الخاطر لا يكشف الفترة المدروسة عبر وضعها في سياقها التاريخي الموضوعي، معتمدا على دراسة تلك الفترة ومشكلاتها وقواها السياسية والفكرية ووضع المنطقة والعالم، فهو يدخل مباشرة الى اللحظة التاريخية وابطالها، معتمدا على أقوالهم وآرائهم عن انفسهم، مستندا الى رسائلهم في اغلب الاحيان، وفي هذا الكتاب الأخير يعتمد على مقتطفات من كتب صدرت حينئذ، واحيانا تكون هذه المقتطفات المستشهد بها كبيرة، بحيث أننا نرى المؤرخ الخاطر يتطابق مع شخصياته المدروسة.
وغالبا ما تكون هذه الشخصيات سلفية، بخلاف عبدالله الزائد الذي كان خارج هذا النسق الفكري، وهذه السلفية السائدة يقول عنها الخاطر انها «تجديدية»، و«تنويرية»، لكن نعجز عن امساك وتحديد هذه التجديدية وغيرها من الصفات الكبيرة.
الشخصيات السلفية التي رأيناها في الكتب البحرينية هي شخصيات تستعيد مذهبا اسلاميا معينا وتدعو له، كما حدده أئمة سابقون، لكن الشخصيات المعاصرة لا تطرح تجديدا وتحديثا، بل تعتبر ذلك بدعة فضلالة !
هذا المنهج يعيد الخاطر نسجه باختصار على تاريخ الكويت الاجتماعي والثقافي، متوجها مباشرة، وبدون مقدمة تحليلية تضع هذا التاريخ في سياقه ومشكلاته؛ فيتحدث عن ثلاثة انجازات كويتية في مجال النهوض، وهي مؤسسات اهلية موجهة للخدمة الاجتماعية والفكرية وهي «الجمعية الخيرية»، و«النادي الأدبي الكويتي»، و«المكتية الأهلية؛».
تبدو هذه المؤسسات التي كونها الشعب الكويتي، وبالتحديد الطبقة الوسطى وخاصة «التجار»، و«الطواشين» مؤسسات منفصلة عن بعضها البعض، غير معبرة عن تحرك اجتماعي سياسي معين، فالخاطر يبحثها كوحدات مستقلة، وليس كتجليات مختلفة لذلك الصعود الشعبي، الذي يحاول أن يتخطى النسيج التقليدي بتخلفه، والوطن بتبعيته للإنجليز..
ولأنه يركز على أقوال وشهادات واشعار الرجال المؤسسين لهذه الحلقات المتعددة المنفصلة، فنحن لا نعرف البنية الاجتماعية المدروسة، التي تتشكل هذه الحلقات لتغييرها، فلا نعرف لماذا نشأت بهذا الشكل دون غيره، ولماذا تجمدت أو انتهت أو تم الحاقها بمؤسسات النظام الاجتماعي؟!
فالجمعية الخيرية الكويتية كانت أحد التجليات للصراع السياسي الدائر حينذاك بين الدولة العثمانية والإنجليز، ورغم أن الخاطر يخلط بين توجهات العديد من المثقفين المعروفين وقتذاك كجمال الدين الأفغاني والكواكبي ومحمد رشيد رضا، حيث مثلوا نزعات ودرجات فكرية مختلفة، فإنه يصل إلى دعوة محمد رشيد التي حث فيها (المثقفين في الخليج على تكوين جمعيات اسلامية ذات نفع عام لخدمة المسلمين كل في بلاده.. لتعزز هذه الخدمة وقوف الخليجيين أمام المد التبشيري الحديث..).
والواقع، انها ليست فقط جمعيات اسلامية ذات نفع، بل جمعيات سياسية تابعة للأتراك، تستغل العمل الخيري للتجنيد وتكوين القواعد للحركة من أجل أهداف سياسية محضة. لهذا كانت هذه الجمعيات تشكل تحركها بأثارة الخوف من التبشير. وهو كان وجها للتوغل الاستعماري. لكن كان عداؤها المستمر للتحديث والتجديد، خوفا من انسحاب القواعد الاجتماعية المحلية من سيطرتها.
لهذا فلا نستطيع اعتبار هذه الحركة تجديدية؛ إلا بشكل محدود جداً، فهي محافظة بقوة، ولن نجد لها بصمات تغييرية عميقة في البنية الاجتماعية المتخلفة، بل هي ستحافظ عليها، خاصة في مجال الوعي.
أن توجه الجمعية الواضح لمساندة الأتراك، وليس لتكوين قواعد نهضوية محلية، يثبت الطابع السياسي الفوقي والخارجي الذي لم يستطع لهذا أن يمد جذوره في التربة الكويتية.
لقد انتهت الجمعية الخيرية الكويتية، التي كانت مؤسسة اجتماعية سياسية أكثر منها مؤسسة ثقافية.
كان يفترض من الباحث أن يقوم برصد هذا العمل الاجتماعي السياسي، وأن يحلل علاقاته بالجمهور الفقير خصوصا، الذي يقوم بمساعدته وتجنيده، ولماذا لم يتم التوجه إلى تثقيف الجمهور وإصلاح الحياة؟ وهل كانت أدوات الاتجاه السلفي قادرة على ذلك؟
لقد تجمد هذا الاتجاه ولم ينم إلا بفضل مساعدات الإنجليز والقوى المحافظة عموما، لهذا وجدنا الحياة الثقافية والفكرية تحتضن من قبل التيارات الحديثة.
ثم يقوم الباحث بتطبيق ذات المنهج الدراسي في قراءة تكون المكتبة الأهلية الكويتية، التي تم تشكيلها سيئة 1922، فوجدنا مسألة المكتبة كحلقة أخرى مفصولة من التطور الثقافي.
فما هي علاقاتها بالنزعات الفكرية وصلتها بالصراع الوطني والاجتماعي؟
ان الباحث يغرق هنا في التفاصيل الماساوية لهذه المكتبة، التي تشكلت من بضعة آلاف من الكتب، وتنقلت بين الدور والدكاكين حتى تآكلت وانهارت وغدت (لا تتجاوز المائتي كتاب، معظمها مقطع الأوصال بعد ان كانت اكثر من الف وخمسمائة كتاب) ص 65 .
لا نعرف ما هي عناوين هذه الكتب، وخدماتها للمثقفين والحياة الفكرية، وتشكيل الأدب والفن ودورها المعرفي المنتظر..
أن حلقات البحث تتقطع، ولا نرى اللوحة العامة للحياة الاجتماعية الثقافية، ونجد الأعمال الاجتماعية والسياسية تغدو في منهج الخاطر عمالا ثقافية، كما لا نجد المستويات الإبداعية في الأعمال الثقافية.
فنحن في الحلقة الخاصة عن النادي الأدبي الكويتي لا نرى دورا أدبيا لهذا النادي وصلاته بالنزعات الثقافية والفكرية، بل سنقرأ مجموعة من الخطب والاشعار التي القيت بمناسبة تشكيل النادي أو التي نظمها بعض المثقفين الكويتيين، خاصة خالد الفرج.
لكن ما هي علاقة كل هذا بسياق النادي، ووظيفته لإنتاج الأدب والثقافة؟ هل استطاع النادي الادبي ان ينتج أدبا ام هو واجهة اجتماعية سرعان ما ذابت؟ وما هي علاقته بالشعر والقصة والمسرح؟
لا نجد اجابات عن كل هذه الاسئلة، وسوف يقوم الباحث بوضع قصائد كاملة لبعض الشعراء في الكتاب، دون أن تتم قراءة نقدية وأدبية لهذه الأشعار.
ويقوم الباحث باشارات إلى التداخل الاجتماعي والسياسي بين الكويت والبحرين، وتأتي هذه الإشارات مفاجئة، وعرضية، دون ان تتحول الى مقارنة عميقة بين التطور المتقارب والمتباين بين المجتمعين الشقيقين.
فالخاطر يعتبر حلقات التطور وإقامة الأندية الثقافية سياقا واحدا، بسبب هذا المنهج العام الذي لا يدخل في التشكيلات النوعية للظواهر، ويقوم بعزلها، وتجريدها، وتشخيصها (أي جعلها شخصية وفردية). فيبدو التاريخان الثقافي والسياسي البحريني والكويتي واحدا.
عموما فإننا نثمن جهد المؤرخ مبارك الخاطر وأعماله المتصلة في قراءة تاريخنا المعاصر، ونود ان يواصل جهوده بمزيد من العمق والتنويع، كما نتمنى أن يظهر مؤرخون شباب يستطيعون استكمال هذا الجهد، عبر أدوات البحث الجديدة والمعاصرة.



