أدب الطفل في البحرين : قصة الأطفال عند إبراهيم بشمي كتب ــ عبدالله خليفة
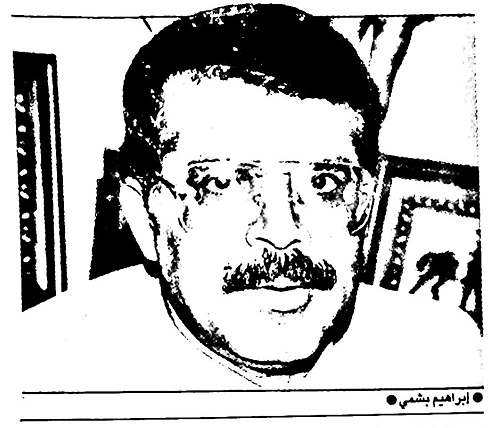
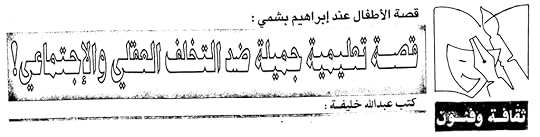
إبراهيم بشمي من أكثر الكتاب البحرينيين انتاجاً لقصة الأطفال، فلديه أكثر من ثمانية إصدارات لقصص الأطفال، وكلها ذات لغة سهلة، مرحة، هادفة، ومنها «العصفور الأعرج»، «سراطين البحر الجبانة»، «الزهرة الزرقاء»، «فرخ البط الخواف»، «جزيرة الطيور»، «النبع المسحور»، «اللؤلؤة السوداء»، «طائر الكيكو».
ويتجه القاص إبراهيم بشمي في كتاباته الموجهة للأطفال، إلى تشكيل حكاية ذات مغزى واضح، وعبر لغة مبسطة، ذات صور وظلال جميلة، وتتركز شخصياته على الحيوانات والطيور، مستهدفاً خلق عبرة.
واغلب قصصه في هذا المنحى التعليمي، وتتجه قصصه ذات الطول الأكبر، إلى توسيع نمط الحكاية وتعميقها، وخلق بنية أكثر تطوراً، تذوب في جزئياتها الإرشادات التربوية والاجتماعية الواضحة المباشرة.
في قصص مثل: سراطين البحر الجبانة، مهرجان الضفادع، فرخ البط الخواف، السلاحف الثرثارة، الاصدقاء، نجد الحكاية المصاغة بغرض التوجيه التعليمي، مستهدفة قضايا جزئية متعددة.
في «مهرجان الضفادع»، نشاهد لوحة صغيرة عن مجموعة من الضفادع، تنهض في عتمة الليل، حيث جميع الكائنات نائمة، وتقوم بالنقيق واللعب.
في البدء يظهر القمر المنير، متذمراً من الغيمة التي حجبته عن الظهور ومشاهدة العالم. وهذه اللقطة الافتتاحية وبطلها القمر سرعان ما تختفي، ليتم التركيز على الضفادع التي قفزت في بركة الماء وراحت تصيح وتغني.
و ليس ثمة حدث خاص بهذه الضفادع سرى اللعب «البريء»، ولكن هذا اللعب والزعيق في منتصف الليل، يزعج الكائنات الأخرى، فها هي السلحفاة تخرج رأسها وتزعق طالبة الهدوء. لكن الضفادع لا تلقي اهتماما لتذمر الآخرين وانزعاجهم، وتواصل اللعب ورش الماء والضحك والقفز. فيتسع الانزعاج من شغبها الليلي، وتتذمر العصافير قائلة: ان لديها أعمالا في الصباح تريد قضاءها، وهي ليست مستعدة للأصغاء الى هذا الضجيج المزعج، كما يصرخ الديك الذي يطالب هو الآخر بالهدوء، لأنه على موعد قبيل طلوع الشمس. ولا يستطيع أن يسكت الضفادع النقاقة سوى حذاء قديم يندفع من يد فلاح ينهض غاضباً من فراشه.
وتتضح بنية القصة التعليمية، من هذا الابتعاد الكلي عن شخوص الضفادع وذواتها وكون النقيق يعبر عن حالة «انسانية»، خاصة بها. ومن التركيز الشديد على الصراع بين الضفادع وبقية الكائنات، حيث تندفع الضفادع إلى اللهو بقوة. وفي كل مقطع، يظهر صوت، يؤكد على أهمية الليل للراحة والاستعداد للعمل. فالضفادع تظهر في مقطع، وتناقضها السلحفاة في مقطع تال، وتظهر بعدئذ العصافير وتصارع الضفادع. ومن ثم الديك، واخيراً الفلاح. وتتضح الغاية التوجيهية التعليمية من هذا التصاعد في المعترضين للضفادع، فكل منها يسعى لغاية هامة عملية في النهار، في حين لا تستهدف الضفادع في ضجيجها ليلاً سوى اللعب وليس الإنتاج.
واذا كانت السلحفاة لم تقل سوى «ألا تنامي؟ اخفضي صوتك المنكر رجاء»، فان العصافير أوضحت الغاية أكثر بقولها: «إن لدينا أعمالا كثيرة في الصباح»، كذلك فعل الديك عندما قال: «أريد النوم قليلاً، حتى أصحو قبل طلوع الشمس».
وتنعزل كافة الجوانب الأخرى من ذوات الضفادع وطبيعة عملها الليلي الخاص بها، والمرتبط بكينونة خاصة، وشخصيات الكائنات الأخرى ونفسياتها المتفردة، ليتركز السرد في تبيان طبيعة الليل وكونه خلق للنوم والاستعداد للعمل، في حين خلق النهار للعمل والإنتاج. وهذه وظيفة بشرية رتبها الناس في ظل ظروف انتاجية طبيعية خاصة، وتحولت هنا إلى توجيه، تجسد في كائنات، ليست لديها هذا الترتيب الخاص. لقد حدثت تناقضات بين المادة القصصية والمادة العلمية، لكن لصالح التوجيه التربوي. ولا تهم الكاتب المطابقة بين المادة القصصية والمادة العلمية، بقدر ما يهمه تسريب توجيهاته الوعظية داخل بنية القصة.
ولكن داخل البنية القصصية تحققت السياقات الناجحة، عبر هذه الفرشة المتعددة للطبيعة والكائنات المختلفة وتنامي الصراع، عبر لغة سردية مرنة، اوصلت الوعي إلى الأهداف المطلوبة.
ومثل هذه البنية تتكرر في قصص اخرى مثل «السلاحف الثرثارة»، حيث نجد الفقرة الأولى تحتوي على مضمون القصة كل: [كانت السلاحف في ذاك الزمان البعيد.. كبيرة الحجم.. مشهورة بالكسل والثرثرة.. والقيل والقال.. ورغم سخرية الحيوانات من ثرثرتها إلا أنها لم تترك هذه العادات السيئة].
في هذه الفقرة الافتتاحية نجد لتضاد واضحاً بين السلاحف وبقية الحيوانات، وهو على سياق التضاد التام بين الضفادع وبقية الكائنات في القصة السابقة. ونجد سبب الاختلاف بيناً واضحاً أيضاً، وهو يتركز في التباين بين السلاحف كحيوانات ثرثارة، وبقية الحيوانات غير الثرثارة.
وتغدو بنية القصة التالية تطبيقاً لهذه الافتتاحية، فسرعان ما يأتي نبأ عاجل بقرب جفاف الوادي، واستعداد الحيوانات المتعددة الكثيرة للرحيل. ماعدا السلاحف التي تسخر من هذه النبوءة. ويأتي عالم الحيوانات الأخرى، المقدم كأمثولة ونموذج، متكاملا من حيث الاستعداد و استكشاف المكان التالي، وتجهيز المؤونة. في حين أن عالم السلاحف، والمقدم كمثل سيء يجب ان لا يحُتذى، ويبدو معادياً لعالم التخطيط والمعرفة ولاهيا في يومه واكله المتواجد الحاضر.
ويبدأ السرد في التركيز على هذا الجانب، فينمو الصراع والاختلاف حول رؤية المستقبل، حين يجادل الهدهدُ السلاحف الصغيرة غير الواعية لما يدور – وهي نموذج للشباب في الأمة – فيقول الهدهد [ألم تعرفوا بعد ان الأمطار لن تسقط في هذا العام وسيعم الوادي الجفاف؟]. وحين لم يعرفوا وقد عاشوا على تربية الجهل من قبل السلاحف الكبيرة، ينتقل الهدهد إلى بؤرة القصة ومضمونها [يبدو أنه حقيقة ما يقال عن جماعة السلاحف بأنها كسولة وثرثارة.. ولا تتعب نفسها بالتفكير بالمستقبل والاستعداد له].
ان الثرثرة تتطابق هنا مع فقدان التخطيط وتضييع الغد، وتبدو السلاحف الكبيرة – العرب، نموذجاً للعادة السيئة هنا، كما كانت الضفادع نموذج العادة السيئة هناك. ولكن العادة السيئة في هذا النموذج أكثر غوراً وأشد خطورة ومرتبطة بكيان الأمة.
ويتضح أكثر طابع المحور الحدثي – القصصي، حين يحدث انشقاق في عالم السلاحف نفسه، بين السلاحف الكبيرة السن، والسلاحف الصغيرة. الأجيال القديمة والأجيال الشابة. ولكن من أين أتى هذا التباين؟ [قالت إحدى السلاحف الثرثارة معلقة على رحيل السلاحف الصغيرة : انها تكرر عبارات جديدة وأفكاراً (؟) غريبة نتيجة اختلاطهم (؟) بالغرباء من الطيور].
وهكذا تغدو السلاحف الصغيرة رمز الأجيال الشابة المتوثبة لتبديل الماضي، وهي نفسها مقدمة امثولة للأطفال ونماذج للاحتذاء. وسرعان ما تتضح الأمثولة. والنهاية الحتمية للتخلف، السلاحف الكبيرة تدخل بياتها الشتوي، فلم تعد تعي ما يدور، فتشققت الأرض من الجفاف، والأعشاب اصفرت ويبست، وجف النبع.. وماتت الاسماك.. وحين انتبهت لم تجد شيئا غير الحرارة.. والزوال.
هكذا تتجه القصة الأمثولة نحو المشكلات الأبعد، والأكثر عمقاً وجذرية. فلم تعد المشكلة صياحاً في الليل وازعاجاً، بل نماذج معتادة على تضييع الزمن وعدم التفكير في المستقبل. وتبدو هذه العادات السيئة نتاجاً لاختيارات وعادات سلوكية بالدرجة الاولى ومن الممكن تبديلها، عبر هذا التباين بين الجيل الهرم والجيل الفتي.
ولا تتناقض هنا المادة القصصية والمادة العلمية. بل تبدو متسقة ومنسجمة. وتتوغل قصص الامثولة أكثر في المشكلة الاجتماعية المعروضة. فهي لا تصبح فقط عادة سيئة، بل فقداناً للقدرة على الصراع ضد الاعداء، و استكانة في مواجهة الأخطار الاجتماعية لا الطبيعية فحسب.
فهذا ما يحدث لـ«السراطين الجبانة». فهذه السراطين كانت تعيش بسعادة ولهو في واديها الجميل في اعماق البحر. ولكن حين جاء الأخطبوط ذو الأذرع الكثيرة و«العيون» الجاحظة غدت مادة شهية له. ورغم قوة أجسادها وذراعها، إلا أنها كانت تستسلم بسهولة للعدو.
ويتضح محتوى القصة – الامثولة في الحوار بين الحلزون والسراطين «إلى أين ترحلين ايتها السراطين الحمراء؟. فتجيب: نبحث عن وطن. يرد الحلزون ملخصا الحكاية: لماذا لا تدافعون عن انفسكم ووطنكم».
لقد طرح الكاتب في البداية العادات الاجتماعية كجذور لتخلف كائناته، ولكن الخلفية السياسية الأبعد، راحت تطرح ذاتها على بُنى القصص، لتغدو معا بنية مجتمع الحيوانات المتخلف – التابع، شكل التجلي لواقع الامة. فتغدو السراطانات امتدادا للضفادع والسلاحف، أو مظاهر متعددة للأمة، الفاقدة للوعي الحضاري المعاصر وقدرة الدفاع عن ذاتها، حتى تعيش قرب الساحل حيث تكثر المجاري والأوساخ، فتبهت أشكالها وتتقزم أحجامها.
في قصة «اللؤلؤة السوداء» المطولة، والصالحة للفتيان، نرى حكاية الامثولة التعليمية، بشكل أكثر اتساعا وتطورا، وببنية متعددة السياقات.
في البدء نقرأ، ذات الافتتاحية القديمة «كان يا ما كان في قديم الزمان، أميرة جميلة تعيش في قصر والدها سلطان بغداد…»، وهو نفس الموتيف القديم، حيث ثمة خلل ما في قصر الخلافة، وفي مركز هذا القصر، حيث الأبنة المدللة مركز الكون القصصي. وفي ذات سياق الموتيف القديم، يسارع السلطان نحو ابنته المكتئبة، مستعداً لعمل أي للقضاء على حزنها.
لكن الكآبة لم تكن لفقد كائن حبيب، أو نتيجة لمرض مزمن. بل لفقدان عقد من اللؤلؤ الأسود الثمين. وهنا يفارق القاص بشمي طابع القصة القديمة المؤثر والعميق، مدخلاً فقدان العقد اللؤلؤي، غير المهم. نظراً لأن أي فتى يدرك مبلغ الثروة الخيالية لسلطان بغداد حيث الامبراطورية ومركزها.. فلا يغدو العقد اللؤلؤي. موقداً لنار الحدث الحكائي المعاصر المنتظر.
ويظهر الموتبف القصصي القديم الثاني، حين يعلن السلطان أن من يجلب العقد سوف يتزوج ابنته. وهنا وقعت بنية الحكاية في اشكالية. فقد كانت الحكاية القديمة منسجمة مع ذاتها، فدعوتها لمساعدة الأميرة والزواج منها، معاً، لا تظهر إلا للجلل الخطير من الأمور. كالمرض المزمن أو الكآبة المستعصية على الأطباء والحكماء. أما فقدان عقد ليس به تميمة ما، أو سر خطير، فليس سبباً معقولاً لان يعلن السلطان تزويج ابنته لمن يعثر عليه. فلا شك أن ابنته اغلى من العقد.
ومهما كان الجدل التبريري الذي جرى بين السلطان ووزيره، حول شكل الدعوة ومصداقيتها، فإن كل المبررات التي طرحها الوزير، غير معقولة. وقد ظهر هذا الارتباك في السياق القصصي نظراً لان الكاتب لم يستفد من البنية القصصية القديمة العميقة الكبيرة.
فالحكاية القديمة كانت تضع الإنسان في بؤرتها القصصية، وليس العثور على اللؤلؤ والذهب مهما كان ثميناً. فشفاء الأميرة وانقاذها هو ما كان يحرك ويلهب السرد والأحداث.
لكن القاص اراد ان يكسر طريقة الحبكة القديمة، وأن يطرح الخطاب الأيديولوجي المعاصر في موادها الممزقة، فيُظهر ان الاغنياء أنانيون وسيئون، وأن الفقراء وحدهم هم من يقومون بالأعمال الباهرة الشجاعة، وهذا هو نموذجهم الكلي القدرة، «عناد»، القادم من مدينة صغيرة في الخليج، الذي يتطوع، لا لكي يسلي الأميرة. بل لينقذ أصحابه الفقراء الغواصين. وحين يجلب اللؤلؤة السوداء يرفض الزواج من ابنة السلطان بل وحتى استلام المكافاة المالية!.
[هذه بطبيعة الحال من أعمال إبراهيم بشمي القديمة، في أواخر السبعينات] لكن رغم المآخذ التكوينية، على هذه القصة، إلا أن الكاتب يتناول هنا مادة تاريخية تراثية، برؤية مختلفة، وعبر شخصيات بشرية، متعددة، وفي مساحة جغرافية متلونة متباينة، بانيا حكاية متنامية مشوقة.
يتبع.. أدب الطفل في البحرين : مسرحية الأطفال عند علي الشرقاوي



