عبـــــــدالله خلــــــــيفة's Blog: https://isaalbuflasablog.wordpress.com , page 19
March 13, 2024
أسباب تدهور وعينا : كتب ـ عبدالله خليفة
لا يتعلق تدهور الوعي الذي يتجسد في الآداب والفنون وفي الثقافة وفي الوعي السياسي بانتشار الأنانية والانتهازية فقط، بل كمعادل لهذا الانتشار تضاؤل الوعي المادي الجدلي، وهو وعي الحفر في الحقيقة، في كشف تناقضات الأفراد والفئات والمجتمعات.
حين تلاحظ اللحظات التاريخية بازدهار المجتمعات، بدءً من الثورة الفرنسية والثورة الروسية والصينية وثورات التحرر الوطني تجد إن مثقفيها البارزين الذين وضعوا بصماتهم على التطور السياسي العاصف، الذي غير مجرى بلدانهم والعالم، فعلوا هذا حين اقتربوا من الوعي المادي الجدلي، حين وجهوا ابصارهم لتناقضات الواقع والثقافة السائدة، متخلين عن أوهامهم الفردية والطبقية، مزيحين هذه الغلالة من الأفكار الُمسبَّقة، ومن الأوهام.
وقد انتهت تلك الموجة من الوعي التقدمي الذي ساد القرن التاسع عشر والعشرين في أوربا وآسيا، وهدم الأمبرطوريات الاستعمارية، بسبب من شعارية هذا الفكر وتبسيطه في العديد من المحاور، فقد وقف عند هدم المجتمعات التقليدية وكان أمراً بسيطاً قياساً لبناء المستقبل الذي أُخذ بأفكار نقصها ذلك الفكر الجدلي، لقد تصورت إنها تبني مجتمعات تنتهي فيها التناقضات، والتناقضات لا تنتهي، وتصورت دولةً تزيل الطبقات، والدولة ذاتها جهاز قمع، وتصورت أنها تنهي الرأسمالية في الوقت الذي تقوم بتشكيلها عبر نفس جهاز الدولة. فهي لم تكن تفهم التناقضات التي تشكلها.
وانظر كيف كان حال وعينا في الخمسينيات والستينيات مزدهراً بحركات التغيير في السياسة والثقافة، ثم كيف تدهور مع الموجات الدينية، فصارت ثقافتـُنا العامة ضحلةً.
إن الموجات الدينية الجماهيرية هذه تعتمد على وعي طفولي ساذج، فهي لا تفهم تعقيدات المجتمعات المعاصرة، وتناقضاتها الطبقية والثقافية، وهي تضعُ فوقها أفكاراً خيالية غيبية، وهذا نتاج قيادات مثقفيها المحافظين الذين يخافون الحركة النضالية الشعبية، فيقسمون الشعوب إلى طوائف ويقسمون العائلات إلى رجال ونساء، ويقسمون الثقافة إلى غيب وواقع.
وهم يعيدون ثقافة ضعيفة الاتصال بالعلوم الطبيعية والاجتماعية، ثقافة كانت تعتمد على معلوماتٍ تقدمُها الِحرفُ والأشغالُ اليدوية، في حين انتقل العالمُ منذ قرون لثقافة تعتمد على التصنيع.
إدخالهم الدين في السياسة ليس نتاج التقوى بل الأنانية، فهم عاجزون عن التطور العلمي، وعن الشجاعة في تحليل المجتمعات وتناقضاتها الحقيقية، فالتناقض بين العمل ورأس المال، التناقض بين الطبقة الغنية والطبقات الفقيرة، التناقضات بين الشعوب والاستعمار، التناقضات بين الثقافة العلمية والثقافة الخرافية، التناقضات بين ثقافة الغرب المتقدمة وثقافة الشرق الهزيلة، كل هذه التناقضات المحورية في العالم لا يقيمون بتحليلها، مثل النشطاء في مجال الثقافة والإنتاج الفكري.
إن الإنسان المتفاعل مع الأحداث يذهب لخطبة رجل الدين ليسمع كلاماً عاطفياً وفيه إثارة غيبية غير محددة، فرجل الدين لا يحلل استغلال الشركات والبنوك، ولا العلاقات الاقتصادية الدولية التي تأخذ بخناق هذا المواطن المتألم، لأنه ربما صاحب علاقات بهذه القوى المادية، فيركز على العلاقات الروحية الغامضة. خطابُ رجل الدين هنا خطابٌ أناني. وخطابُ رجل الدين هذا سلسلة من خطابات مثقفي التقوى هؤلاء الذين لا يريدون إثارة الشركات والوزارات ويكشفون الأسعار والأجور والتلوث والاستغلال، محلقين في عالم من التخيل الخاص والتجارة بالرموز المقدسة لأصحابها.
ويقول الفنانُ لماذا أرسمُ آلامَ الإنسان وهل يمكن أن تـُعرض في معرض؟ بطبيعة الحال سيقف القائمون على المعرض دونها. ومن سيشتريها؟ ويمكنني أن أرسم ألواناً وأشياء تجريدية أو صوراً فوتغرافية جميلة للصحراء والجمال والنخيل وهي تـُشترى.
ويقول الكاتب لا استطيع أن أقوم بتحليلات وتحقيقات ومسرحيات وأفلام تكشفُ جشعَ الأغنياء والحكومات وأعري العائلات المحترمة لاكتفي بمسرحيات ضاحكة تخفف عن الناس أحزانهم، ومسلسلات تتكلم عن قضايا صغيرة عائلية وخاصة مسألة الطلاق، فكم يؤدي الطلاق إلى كوارث!
يعيش المنتجون للأفكار والثقافة السائدة في عالم من الكذب الواسع، وهم نتيجةً لجلهلهم بالدين ولعمومية مقولاته، يستعينون به لكي يستروا تنازلاتهم لقوى الاستغلال، فإذا سرق المثقف قال سأذهب للحج لا لشيء سوى أن يخفي ما قام به، وهذا تدهورٌ غاصَ فيه الآن المثقفُ عوضاً أن يكشف السرقات العامة، ويذهب للحج، فتغدو المظاهر العبادية جزءً من عالم الاستغلال، ويتوسع الأمر في ظل تحويل ذلك إلى عملية تلاعب سياسية واسعة بالدين، وكون التزام المرشح بالعبادات هو ضمان لصحة انتخابه ولصحة العمليات السياسة الوطنية!
ويعمق الجمهورُ الجاهلُ هذه الحالة، فبدلاً من أن يطلب من السياسي المرشح شهادةً عن نضاله ضد الاستغلال ولرفع حياة الجمهور المعيشية، يطالبه بكشف حساب لعدد صلواته! فالجمهور يزيد أوضاعه سوءً، فإضافة للاستغلال الحكومي على كاهله يظهرُ استغلالُ النواب.
إذن الوعي المادي الجدلي، الوعي بالتناقضات الطبقية والاقتصادية عامةً وتحليلها وكشفها، ومعرفة الوسائل السياسية المرافقة لهذا الوعي والمتوجهة لتنظيم الجمهور لكي يناضل لحلها، هو العاملُ الفكري المرافقُ لنمو الشعوب نحو الحرية والتقدم، فهو وعيٌّ يحددُ المشكلات الرئيسية ويوجه الإرادةَ البشرية نحو حلها. فتنظيمُ الشعب الصيني الذي يبلغ أكثر من مليار يعتمد على نخبة صغيرة وجهته نحو حل مشكلاته الحقيقية في الواقع، وليس في الخيال الديني أو الرومانسي أو الذاتي الأناني. إن مشكلاته هي في ضعف المصانع والتجارة والعلوم الخ.. وتأتي الحلولُ محددةً، وبعد ذلك من يؤمن بماو فليؤمن ومن يؤمن ببوذا فليؤمن، فساحة الواقع لها مكانتها ومناهجها وساحة الغيب لها مناهجها.
خلقت الشعوبُ بهذه المادية الجدلية ثورات نهضوية كبرى انتقلت بها من خنادق المتخلفين إلى فضاء المتقدمين.
الأم والكتاكيت السياسية : كتب ـ عبدالله خليفة
تتعامل الأنظمة الشرقية خاصة مع قوى المعارضة وكأنها كتاكيت صغيرة لابد أن تـُحضن حتى تكبر. إن الطابع الأبوي يتبدى في (القصَقصَة) المستمرة لأجنحة هذه الكتاكيت حتى لا تطير وتعرض نفسها للأخطار! ومن هنا يجري ربط هذه الكتاكيت بالوزارات الأمومية كالشؤون الاجتماعية أو العمل، فالطابع الأبوي الحنون متوار، فيجب ألا تـُخدش الجماعات السياسية الطفولية بكونها قاصرة وتحتاج إلى رضاعات مالية تصنع لها بعض الريش واللحم لكي ترابط عند أمها الحنون ولا تطير. وكلما ازداد عدد الكتاكيت كان ذلك أفضل من أجل أن تلوذ بالأرض وتتصارع على الحبوب.
إلى ماذا يرجع هذا الرسوخ للثقافة الشمولية في الشرق عند الدول والجماعات السياسية والشعوب؟ إن الدجاجة الكبيرة، الدولة، تمتلك مخازن الحبوب، لقرون طويلة، وكونت العادات والثقافة عند الشعوب لكي تتخصص هذه في التقاط الحبوب من الأرض حيث تـُلقى عليها، فترى الجمهور الشعبي وقد عاش طوال حياته يكره السياسة، وهي الثقافة التي تجعله يرفع رأسه لفوق، ويبحث عن سبل العمل المستقلة، فينحو في حياته ليس لالتقاط الحبوب بل لزرعها وصناعتها أو لانتزاعها من المخازن المغلقة.
وراء الكتاكيت السياسية يجثم الشعب مصدر السلطة الضائعة، الذي تخصص في ألا تكون له سلطة، بل أن تتسلط عليه الدول والحكومات والهيئات المختلفة والأقدار، وأن يُسجن في الأعمال اليدوية الصغيرة الشاقة المحدودة، أو في الأعمال الذهنية الجزئية، فيفقد كل قدرات العقل على التحليق الحر، فتأتي كل ثقافات التسلية والغيبيات لكي ينتظر ويقنع بعيشه الصغير، وبزنزانته السياسية الاجتماعية العظيمة، فيكره التجديد في أي شيء، ويكره البدع، والعلوم الجديدة، وتغيير العادات وتعرية الزعماء السياسيين ونقد الأفكار السياسية الخاطئة أساس عبوديته وعدم طيرانه.
وما دامت الشعوب نائمة ومقيدة في شموليتها العريقة، وسلبيتها، وثقافة التقاط الحبوب من الأرض وكره السياسة والتجديد، فما تنتجه من تيارات سياسية لا يخرج عن قوى شمولية لا تستطيع أن تتجاوز شعوبها الشمولية، بل تغدو إعادة إنتاج لما هي عليه وتكرار لما سبق، وألحانا متعددة لذات النغمة الأساسية، فهي دجاجات أخريات تريد أن تحل محل الدولة. وهكذا فإن الشرق لا يشهد تجارب ديمقراطية لأن نسيجه الاجتماعي الحكومي والشعبي لا يعرف ما هي الديمقراطية أصلاً.
فليست الديمقراطية الشرقية سوى تسويات وصراعات داخل حلبة الشمولية والاستبداد، فهنا تتوزع معسكرات الاستبداد بهذه الدرجة أو تلك من تمثل بعض المصالح العامة والشعبية، ولكنها في العمق تعضُ على كراسيها أشد العض، وتتمسك بامتيازاتها الموروثة أشد التمسك. فعلينا ألا نـُصاب بلوثات عقلية بأن ما يجري هو ديمقراطية، وهي لوثات تحدث من كثرة ترديد هذه المفردة نظراً لعمليات غسل الدماغ التي تجري يومياً.
لا شك إن الديمقراطية قادمة للشرق لا محالة، ولكنها ذات قوانين اقتصادية تتمثل في ظهور طبقة حرة ولديها وسائل إنتاج قوية قادرة على الوقوف في وجه الدول المحتكرة لوسائل الإنتاج والعيش والإعلام.
وفي الطريق إلى ذلك لابد من ثقافة ديمقراطية تتغلغل بين الشعوب، إلى الجمهور الأمي القليل التعلم، وللجمهور المثقف الذي يعيش على مخلفات الثقافة العبودية، وأن يعي بأن ثمة قوانين واحدة لتطور البشرية وأن الديمقراطيات الشرقية هي استبداديات جديدة بأزياء مستوردة شكلية من الغرب، فهي لم تذهب لجوهر تجربة الغرب الديمقراطية، بل استعارت الصبغة الخارجية للجسم وتخلت عن العمق، الذي يعني شعوباً ديمقراطية خرجت عن سيطرة الدول والأديان وتقوم بإيجاد سياسة تعبر عن مصالح طبقاتها الأساسية وليس عن شلل الحكم والزعماء.
وإذا كانت شعوب الشرق تمر الآن بمرحلة انتقالية نحو الديمقراطية فلا بد من ألا يكون مخزن الحبوب تابعاً للحكم، وأن تحدث عمليات تدرج بين إشاعة المنافع الاقتصادية للطبقات الفقيرة والانتقال للديمقراطية ولانتشار الوعي لا الدجل الانتخابي، فإذا كانت الديمقراطية هي إعادة توزيع جديدة للثروة للطبقات الغنية والحاكمة فتكون هي الفوضى وليس الديمقراطية!
March 12, 2024
الثورة والكهنوت: كتب ـ عبدالله خليفة
كانت مرحلة التحولات الإسلامية في المدينة مختلفة عن الصراع في مكة، فهنا كان الصراع مركباً، فثمة دينان سماويان في هذه البقعة، وكان الدينان هما كذلك من مرجعيات الإسلام.
ولكن الإسلام كان يتجذر في بيئة عربية، وهو يمثل كذلك ذروة تطور الحنفية، وهي الشكل من الدين الذي تأسس في الجزيرة العربية ونما عبر العلاقة مع خصوصياتها، في حين كان الدينان الآخران (اليهودية والمسيحية).
لقد كان ميراث الدينين السابقين اللذين يتجليان في الذاكرة الشعبية بأنهما توحيديان مضيئان، ولكن مسيرة الإسلام في المدينة خاصة اصطدمت بهما، وبأحدهما على وجه الخصوص وهو الدين اليهودي كما تجلى عند العرب اليهود البدو.
كانت ثمة فترة من المهادنة والاحترام المتبادل غير أن الصراع كان لا بد أن يقع، بسبب أن كل جماعة كانت تمثل سلطة، لكن السلطة الحقيقية كانت لدى قبيلتي الأوس والخزرج اللتين رضيتا بالإسلام قيادة ليس للمدينة فحسب بل للعرب جميعاً، وبهذا كان لابد للعرب المسلمين حديثاً من بسط نفوذهم على المدينة والاصطدام بالجماعة اليهودية.
كانت هناك فترة للتفاهم والحوار وتشكيل وحدة بالعودة إلى مبادئ الأنبياء السابقين المؤسسين، لكن هذه المحاولة لم تنجح، فأخذ المشروع العربي الإسلامي يصارع على جهتين عدو خارجي يتمثل في وثنيي مكة ويهود الداخل المتعاونين لإجهاض المشروع.
وكان الأساس الصراعي بأن الدينين الآخرين يمثلان ثورتين في الماضي، حين كان الأنبياء يقاتلون سلطات باغية، حينذاك لم تتأسس هيئات كهنوتية في الدينين تستحوذ على خيرات الناس، أو تعاضد الحكومات، وكان الإسلام في هذه اللحظة التاريخية التأسيسية في حالة ثورة.
إن وجود هيئات كهنوتية متسلطة وراءها ثروات كبيرة كان يمنع من تحقيق وحدة دينية كان يطرحها الإسلام: [قُل يا أهلَ الكتابِ تعالوا إلى كلمةٍ سواءٍ بيننا وبينكم ألا نعبُدَ إلا اللهَ ولا نشركَ بهِ شيئاً ولا يتخذَ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اللهِ فإن تولوا فقـُولـُوا اشهدوا بأنا مسلمون]، (آل عمران، 64).
كان الإسلام حركة شعبية متنامية بلا تلك السلطات، وهو لا يوجه كراهية عنصرية للدينين فقط لأنهما دينان، بل للأسباب المذكورة أعلاه، ولهذا فإن الآيات في هذه السورة وفي سور مدنية عديدة، تشير إلى رجال الدين البسطاء من هذين الدينين الذين تعاطفوا مع الحركة كآية 113 في السورة نفسها.
ومن هنا ولأجل الممارسة الديمقراطية ولعدم خلق كهنوت ترفض الآية (79) في ذات السورة مبدأ الكهنوتية، وخلق جهات متسلطة على الناس باسم الدين وهدفها الثروة لا الثورة وترى بأن (الكتاب والحكم والنبوة) ليست أدوات لخلق عبودية وتحكم وتسلط، بل هي الطرقُ للدرسِ والعلوم.
إنهما موقفان تاريخيان مختلفان، يعبران عن مصير أمم، والمنجزات الإيجابية التي استثمرها الإسلام التأسيسي توقفت على جوانب اجتماعية متعددة، مؤقتة كالديمقراطية الشعبية العفوية، وتعدد الزوجات ورفض الربا، وهي جوانب كانت مرافقة لتطور اجتماعي معين، وحين ذهبت الجوانبُ الإيجابية بعد الفتوح نشأت حكوماتُ الأقلية والكهنوت، وركزت على ما هو سلبيٌ وتركت الجوانبَ الإيجابية، وهو ما شكل مصائر مختلفة لهذه الأديان والأمم عبر مسار التاريخ التالي، فصغر العائلة وتوظيف الفائدة المالية للنمو الاقتصادي التي كانت ميزات الدينين الآخرين الإيجابية والمرفوضة عند العرب بسبب خروجهم المتأخر من (الجاهلية) قد خلقت فيما بعد ثورة ديمقراطية وحضارية في الغرب بعد تطورات تاريخية طويلة.
في حين ان المسلمين على العكس ركزوا في سلبيات البداوة واحتفظوا بها، ووضعوا عليها ديكورات دينية نظراً للتخلف السائد واستمراره وتركوا الجذوة.
لم يستطع أهلُ الكتاب مجاراة العرب في عملية الثورة التي نبعت من ظروفهم ومن مستوى تطورهم المتخلف والحر كذلك، لكن أهلَ الكتاب عملوا قروناً طويلة، بعضهم كدس الرساميل والبعض الآخر اشتغل على التقنية والعلوم وقد ساندتهم البنية الاجتماعية الأسرية الصغيرة فحققوا ثورة جديدة.
March 11, 2024
دولة «الحشاشين»: كتب ـ عبدالله خليفة
اعتمدت إستراتيجية حسن الصباح زعيم الإسماعيليين في إيران في قرون غابرة على خلق فرق الإغتيالات، وإرسال المنفذين إلى عواصم المدن العربية من أجل قتل وتصفية الزعماء الذين يعارضون سياسته، والذين يقفون أمام بسط نفوذه.
وتعبر سيطرة سياسة الإغتيال عن تراجع الحركة الإسماعيلية عن النضال الديمقراطي الشعبي، الذي كانت تعتمد عليه حين كان لديها زخم جماهيري ما، وتحولها إلى حركة مغامرة لم يعد الناس يثقون بطرقها وأهدافها.
لكن الحركة كانت مصرة، ومع نفاذ المخزون الشعبي من المؤيدين لها راحت تعتمد على العنف، وعلى إغراء بعض الناس بامتيازات تعلو فوق القانون الديني نفسه التي ارتكزت عليه، بحيث أنها استخدمت الحشيش لتخدير منفذي الاغتيالات وجعلهم يعيشون لحظات تخدير عالية فيتجرأون على القيام بتلك العمليات الوحشية..
ربما كان ذلك من الأساطير التي نـُسجت حول الحركة وأعمالها الغريبة الجريئة، لكن التخدير كان موجوداً بشكل معنوي، كما تفعل الحركات والدول الإرهابية بتخدير أفرادها عبر شرائط غسل الدماغ.
إن الدول الشمولية الشرقية المعاصرة لا تحتاج إلى استخدام الحشيش كي تصنع إرهابيين، فقد تكفل بذلك تطور الوعي الجماهيري الاستبدادي الذي تشكل خلال العقود الأخيرة، والذي احتضنه الاستعمار الغربي والدول المحافظة، والذي لم يضطهد الغرباء فحسب بل مارس قمعه على أهل بيته في بدء الأمر.
فقد توفرت للدول الاستبدادية جماعات جاهزة للقيام بعمليات التصفيات الجسدية للمعارضين، وخاصة حين يصل لهذه السلطات زعماء فاقدين للتجربة السياسية الطويلة، وجاءوا عبر المؤامرات الحزبية والعائلية.
تشكلت هذه الجماعات في أقبية الدول وفي السجون وعبر التعذيب والاعترافات وإنقلاب الأدوار من مناضلين إلى جواسيس، حيث تقوم أجهزة الاستخبارات بسحق آدمية الإنسان، ثم تنقله إلى أجواء خلابة من الامتيازات و(الحشيش) التخديري الإمتاعي، وتسجل عليه مثل هذه اللحظات في إعترافات وشيكات وأفلام، بحيث يكون طوع أمرها في القيام بأي عمليات قذرة مطلوبة لكي يحتفظ بشرفه النضالي الزائف!
إن السيطرة القمعية الطويلة على هذه المجموعات وتحطيمها وإذلالها، يتيحُ تكوين مجموعات فاقدة للذمة، مخدرة، خاصة إنها بدأت أعمالها (البطولية) بالمغامرة والجريمة، فصار من السهولة بمكان توجيهها إلى قتل رئيس وزراء معاد، أو قادة سياسيين ناقدين ويشكلون حجر عثرة أمام حسن الصباح الحديث في قلعة آلموت المحصنة القوية وسط الحرس الجمهوري وفرق الجيش وقوى الاستخبارات!
حسن الصباح الحديث ليس زاهداً، ولا هو مؤمن بقضية جدية، كما كان سلفه، بل هو ابن ذوات، وإنسان مدلل، وجد نفسه بدون تراث ديمقراطي، وفي عائلة فاسدة سياسياً لديها مليارات عليها أن تحافظ عليها بأية صورة، وهو لم يكن لديه وقت لكي يمارس السياسة وسط قوى الشعب، مثل أجداده الميامين، فجاءت له الثروة والسلطة على طبق من ذهب، وتعلم من هذه الأجهزة أن الكفاح يتم عبر المدفع، وإن الاغتيالات أسرع طريقة لإجبار الخصوم على الخضوع!
فكان اتصاله بالقوى السوداء الموجودة في الأقبية والدهاليز الغامضة، وكان تراثه يدعوه لخلط العسل بالسم، وهي طريقة تراثية تاريخية مهذبة، لكنه فضل استخدام الألغام والسيارات المفخخة والطرود البشرية الملغمة، نظراً لاختلاطه بتلك الأوساط المتوحشة، ونظراً لرخص الإنسان وغلاء العسل والحشيش عنده!
إن اعتماد سياسة المغامرات والانعزال عن الجمهور وعن التراث السلفي الإنساني والتراث التحديثي الديمقراطي، هي كلها مظاهر لأزمة واحدة، وهي تقود حسن الصباح الجديد إلى العزلة أكثر فأكثر، ويلعب السلفيون المعتمدون الإصلاح دوراً رئيسياً هنا، لأنهم رفضوا طرق الحشاشين في الوصول للسلطة وفي استخدام العنف متجهين أحياناً للتطرف في ذلك، حيث يعتبرون التحديث بمختلف فرقه هو الذي صعد حسن الصباح الجديد، الذي لم ير سوى العنف القابلة المولدة لكل حزب سلطوي يقبع فوق صدور الناس ولكن ذلك ليس صحيحاً فصعود حسن الصباح الجديد هو ثمرة لتعثر الإصلاح والديمقراطية في هذه الأنظمة!
المتقدمون وغزو الفضاء: كتب ـ عبدالله خليفة
استطاعت الأمم الغربية والروسية، أن تحتكر مشروعات الفضاء الكونية، وهذا أمرٌ يمثل تفوقها الصناعي، ومضت بعض الأمم الشرقية كالأمة اليابانية والصينية في اللحاق بهؤلاء المتفوقين لما أنجزوه خلال قرن من تنظيم شامل ومتقدم لمجتمعاتهم.
وأصبحت خارطة الفضاء القريب، وهو المجموعة الشمسية تتضح بصورة أكثر دقة، بسبب بعث العديد من الأقمار الصناعية وأجهزة التصوير وبفضل الرحلات الفضائية للقمر وللفضاء الخارجي عموماً.
وإذا كانت الكواكب السيارة حول الشمس قد تم تفكيك مناخاتها الداخلية وموادها العامة، فإن القرن الماضي يعتبر هو زمن كشف الأقمار الكثيرة الدائرة حول هذه الكواكب المقاربة للأرض أو العملاقة كزحل والمشتري.
وقد غدت مشروعات الفضاء القادمة مركزة على غزو القمر وقمري المريخ والمريخ نفسه، باعتبار هذه الأجسام الأقرب للأرض كما أنه أصبح ممكناً أن تحوي بعض العناصر الأساسية للعيش البشري كالماء والهواء.
لقد تم كشف معلومات كبيرة حول هذه الأقمار، والتي من الممكن أن يغدو بعضها قاعدة للتقدم في المجموعة الشمسية، وترينا المحطات الفضائية العلمية سيناريوهات عديدة للعيش البشري الذي لا بد له أن يتأقلم مع كل قمر وكوكب. لقد غدت هذه العملية تجري بشكل تصويري وداخل مواد كل كوكب وقمر، حيث أن كل واحد منها يمتاز بمناخ مختلف وبتكوين من المواد الخاصة، فبعضها يمتلئ بغاز وآخر بجليد وثالث بمواد كيماوية أخرى وأحد الأقمار يحتوي بحراً أكبر من محيطاتنا، ولم تــُكتشف الحياه فيه بعد، كما أن آخر ذا مواد بركانية متفجرة.
كما يكتشف دور المشتري ككوكب هائل يمتص الكويكبات والأجسام الشاردة الهاجمة على نظامنا الشمسي.
وهكذا فإن تنوعاً مدهشاً يحتوي مجموعتنا الشمسية الصغيرة جداً في الكون الفسيح!
وتجري صراعات بين الأمم المتقدمة على السيطرة على الأرض وعلى التقدم المتفرد في الفضاء، كما يدور تعاون محدود بينها وهو ما يمثل وحدة البشرية الحتمية في مواجهة الخروج الأولي من الأرض نحو جيراننا الأقرب!
ومن الملاحظ تقدم الولايات المتحدة في هذا الصعود الكوني، حيث يعطي تقدمها الصناعي الكبير هذا التوسع في الفضاء، وهي لديها سيناريوهات لاحتلال بعض المواقع المتقدمة في المجموعة الشمسية، نظراً لأن كل دولة لا تستطيع سوى أن تخطط لبرامجها الكونية، واضعة بعض الموارد التي تنبع من قدراتها الاقتصادية ومن استقرار نظامها السياسي.
فيما أن الدول المتقدمة الأخرى أقل قوة اقتصادية وأكثر عرضة للصراعات، فتحتاج لأغلب مواردها في العمل الأرضي، فيما يمثل الجهد الكوني إضاعة للموارد الأرضية لمشروعات طموحة لا مردود آني لها.
وهكذا كلما أزدادت قاعدة الأمة الاقتصادية تصنيعاً وعلماً كلما ارتفعت قامتها نحو أعالي السماء فتناطح ليس السحاب بل الأقمار والأجسام العملاقة في المجموعة والتي ليست سوى ذرة من مجرة هي الأخرى حبة فاصولياء بين المجرات!
إن الجماعة البشرية تطل الآن بشكل تقني على المجرات الأقرب، وأمامها سديم ضخم شبه مجهول، ولا شك أن ثمة حضارات نائية عنا، وإمكانيات مجهولة منا، ولكن يحدد ذلك عمر الكون الراهن، حيث أن الكون له عمر ويتجدد عبر مليارات السنين، وهذا العمر يشير بالنسبة للمجموعة الشمسية أنها ذات عمر معين في حين تسبقها مجرات أخرى بالعمر، وهي ذات إمكانيات كبيرة للتنوع وللحياة!
وحتى في الأرض فإن أزمنة الدول والحضارات مختلفة، ففي حين يشرف بعضها على الخروج من الكوكب، يظل بعضها يتصارع حول الطين الأرض البدائي، غير قادر على تطوير إمكانياته.
إن الخمسين سنة القادمة ستكون حاسمة لمشروعات الفضاء، وحتى بمواد الطاقة الراهنة فإن زراعة الإنسان في القمر والمريخ تغدو ممكنة، فتبدأ أولى الخطوات التحرر من الجاذبية الأرضية ومن الحبس على هذا الكوكب الذي أستمر ملايين السنين!
March 9, 2024
إصلاح أم ضياع : كتب ـ عبدالله خليفة
ينخرط العاملون السياسيون في عملية الصراعات الاجتماعية المتفاقمة الجارية في الوطن العربي بلا رؤية، تدفعهم العفوية والتجريب والقضايا الجزئية، لا يعرفون ما هو الدرب المعقد الذي يتدحرجون فيه.
إن كلمة (الإصلاح) الخادعة هذه تسبب العديد من الإشكاليات، فهل ما يجري هو إصلاح أم صراعات على السلطات في كل بلد عربي، بهذا الشكل أو ذاك؟
إن ما يجري هو صراعات على السلطة، فالفريق الجديد فى السلطة يحاول أن يسحب شيئاً من سلطة الفريق القديم، وقد يكون الفريق الجديد داخل الطبقة المهيمنة وقد يكون خارجها، لكن الفريق الجديد، من كان، سواء داخل الطبقة الحاكمة أم خارجها، ليس لديه شيء جديد في الواقع، فهو اجترار للنظام التقليدي نفسه، وهي كلها صراعات داخل التشكيلة، والتجريبُ يقوم على لحوم الشعوب.
إن الأخوان هم خارج الطبقة الحاكمة، ويعبرون عن فئات وسطى، لكن الأيديولوجية المذهبية التقليدية، لا تجعلهم قادرين على التعبير عن هذه الفئات التي ينتمون إليها لأنهم لا يؤمنون بأنهم معبرون عن فئات وقوى اجتماعية محددة، فيصيرون مشابهين للطبقة الحاكمة نفسها، بقالب ايديولوجي مختلف، لكن الجوهر الاجتماعي هو نفسه، فالبيروقراطية الحاكمة عبر نصف قرن ستعيد تكييفهم إذا لم يتشكل وعي حديث بينهم ينفصلون به عنها.
وإذا تمظهر ذلك في صراع فتح وحماس، أم في مجموعة من الطوائف ضد الدولة في لبنان، أم في التجليات كافة التي تجري في البلدان العربية والإسلامية، فهو كله تعبير عن طبقة تقليدية مهيمنة وغياب النقيض، سواء في برجوازية صناعية ذات فكر نهضوي منتشر شعبياً، أم في طبقة عاملة.
إن الفئات الوسطى التي تصارع الطبقة التقليدية ليس لديها نظرة ديمقراطية واسعة الانتشار شعبياً، ولهذا حين تدخل إلى السلطة، أو يدخل بعضها، فإنها تقوم باحداث أزمة في مؤسسات الدولة بدلاً من أن تتجاوز الأزمات الطاحنة.
إنها تقوم بتشكيل فوضى عبر تفكيك جهاز الدولة وشله عن العمل، وبالتالى يفتح ذلك الطريق لصراعات داخلية محمومة أو حرب أهلية.
كذلك فإن الطبقةَ السائدة ذاتها تنقسمُ في العديد من البلدان نظراً إلى هذه الأزمة البنيوية، فبعضها يجنح نحو اساليب جديدة في إدارة الأزمة، والبعض الآخر يحرنُ الأسلوب القديم.
وهذا قد يُضاف إلى أزمة الفئات الوسطى المشلولة في فكرها والمنقسمة، فتتداخل المشكلة وتغدو مركبة. لأن جزءاً من الطبقة الحاكمة يستعينُ بقوى من الفئات الوسطى، في حين يستعين جزءٌ آخر بتكوينات أخرى، وهذا يوسعُ دائرةَ الأزمة في البناء الوطني ككل وبدلاً من أن تكون بين الحكام تغدو بين الحكام والمحكومين.
والعملية ليست إرادية ذاتية محضة، بل هي كذلك أزمة بناء اقتصادي لم تختمر فيه إمكانيات التحول الحقيقي، أي لم تظهر طبقةٌ قادرة على تجاوز النظام التقليدي.
لقد ظهرت في أوروبا الغربية كلمة (الإصلاح) بعد العصر الوسيط، وعبرت عن حروب دينية، أي عن صراع قوى إقطاعية لم تبلورْ نظاماً حديثاً بعد، لكن بعد تفجر الثورة الصناعية ظهرت مصطلحات أخرى عبرت عن العصر الحديث، ولهذا فإن المتصارعين التقليديين العرب باستعمالهم كلمة الإصلاح، يعبرون عن هذا المستوى. فالمصطلحُ يشيرُ إلى تغييراتٍ في نظام اقطاعي، وليس دخولاً في النظام الحديث.
وبطبيعة الحال فإن مستوى التطور العربي مختلفٌ من بلد إلى آخر، لكن أساسيات البناء هي نفسيا، لهذا نجدُ الأزمة تتمظهرُ في كل بلدٍ عربي عبر تجربته الخاصة وتقاليده السياسية.
إن (فتح) رفضت أن تحسم خيارها الاجتماعي بين البرجوازية والعمال، وشكلت وعياً وطنياً ضبابياً تجريدياً ، عبّر في الحقيقة عن هيمنة كوادر بيروقراطية على الجمهور العامل، وأثناء النضال الوطني كانت التناقضات بين هذه الكوادر وقوى الناس مغيَّبة، يخفيها الحماسُ والمشاعر الفياضة ويضحى فيها الفقراءُ لصعود تلك الكوادر، وقد شكلت فتح وعياً غيبياً دينياً وبرجتاتية سياسية يومية، أي انها تعتمد على المظلة الفكرية ذاتها للناس المقموعين الذين يعيشون في النظام التقليدي وعاجزين عن فهم مصالحهم وبلورتها، حتى إذا وصلت فتح إلى السلطة، ظهر التناقض الطبقي بين البرجوازية والعمال، واتخذ مساراً معقداً.
لم تقم فتح أو أي منظمة عربية سائدة بإنتاج وعي علمي، وإذا كانت قد شكلت برجماتية سياسية مفيدة لكن ركائز الوعي الديني التقليدي والقومي العتيق لم تتغير، وهي باعتبارها كوادر برجوازية راحت تستغل الجمهور الفقير، وتجسد ذلك سياسياً بقضايا الفساد، ولهذا فإن هزيمتها في الانتخابات ليست موجهة لبرجماتية التفاوض، بل للفساد أي لاستغلالها الموارد والمناصب، ولم تفهم (حماس) الموقف، فعارضت ما هو جيد ومقبول شعبياً وهو سياسية التفاوض القائمة على الاعتراف الضمني بوجود دولتين، لكن الشعب انتخبها لمعارضتها الفساد فقط، ولهذا دفعتها هذه السياسة إلى تفجير الوضع برمته بدلاً من (إصلاحه) فتوجهت لهدم ما هو جيد وغابت عما هو سلبي داخلي، ولهذا بدلاً من رفع أجور العمال توقفت هذه الأجور كلياً!
إن حماس هي امتداد لفتح، فهما قوتان لم تنتقلا إلى الحداثة السياسية، أي أنهما تزيفان انتماءهما الاجتماعيين، فلا تعلنان موقفهما الطبقي، بالانتماء إلى البرجوازية أو العمال، مثلما فعلت فتح بغطائها الديني القومي الضبابي، واستعملته لتصعيد الكوادر البرجوازية في هيكلها التنظيمي وجسمها يقوم على تضحيات العمال والفقراء، وتواصل حماس ذات السياسة ولكن من خلال غطاء ثقافي مذهبي يميني، وفي خلال هذا الدخان المذهبي تصعدُ كوادرُها للسيطرة على جهاز السلطة. ولكن بدلاً من برجماتية فتح في السياسة طرحت جمود الموقف القومي الديني القديم الذي لم يستفد من تلك البراجماتية. فأضافت سوء سياستها الخارجية إلى هلامية موقفها الاجتماعي الداخلي، فنقلت البلد إلى أزمة مركبة على صعيدي السياسيتين الداخلية والخارجية، فقطعت شرايين (السلطة) بالحياة الدولية ذات الأسس الحضارية التامة، نظراً إلى ذلك الموقف المذهبي اليميني.
إن هذا الغطاء المذهبي هو لتسلل كوادر برجوازية أخرى للسيطرة على عمل العمال، فهو غطاء ضبابي يستعمل مصطلحات (إسلامية) عامة غامضة، من أجل إزالة الوعي الطبقي من الجمهور بمختلف انتماءاته الاجتماعية، لأن الجمهور الفقير سوف يسأل حماس عن مواقفها وكيفية توزيع الثروة وخطوات (الإصلاح) على الأرض، وهذا يقودإلى تفتيت الكيان السياسي الهلامي لها، الذي لم يحسم خياراته الاجتماعية وموقفه من الحداثة والعقلانية والعلمانية والديمقراطية، أي من توزيع الفائض الاقتصادي على الفقراء، فتصير أزمة حماس امتداداً لأزمة فتح، أي هي أزمة الفئات الوسطى العاجزة عن التشكل الطبقي، واختيار طريق التطور. ولكن بدلاً من أزمة تنظيم واحد تغدو أزمة تنظيمين ثم أكثر لتصبح عاصفة وطنية ثم إقليمية.
فبدلاً من عرين الأسد العراقي الذي ارتمت على فيض أمواله فتح، تظهر خزائن البعث السوري وإيران، وبدلاً من القومية المهترئة بفعل المخابرات تظهر دول الطوائف، ولهذا تغدو السياسة (الإسلامية) هنا برجماتية تقوم بها الكوادر البرجوازية لاحتلال الكراسي، وهو أمر يفجر الوضع السياسي الوطني الفلسطيني ويفجر الوضع في المنطقة.
إن المتاجرة بالوطن تُستبدل بالمتاجرة بالمذاهب، وقشور الشعارات الوطنية تضاف إلى قشور الشعارات المذهبية، ومن هنا لا تتخذ حماس موقفاً من نضال المسلمين النهضوي الطبقي الأساسي، أي من نضال عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب لتشكيل دولة شعبية، فلا فرق لديها بين هذا وسياسة ملأ قريش، وهو أمر يتشكل في فقه العبادات المفصول عن الملكية العامة و الانحياز للطبقات الشعبية.
وما يحدث في فلسطين يحدث في مصر، والعراق، واليمن، والجزائر الخ، فالبناء ذاته، فالحزب الوطني وريث الامتيازات، ومظلة الوطن المسروق، يجابه حزب الاخوان، دون أن يمتلك الأخير سياسة تنفي نوعياً سياسة الحزب الوطني، بل هي تنقل الأزمة إلى مستويات جديدة من البناء، وبدلاً من تقديم حلول للنظام المأزوم يتم تفجير المعارك في الشوارع. أي بدلاً من الوقوف مع الفلاحين وتقديم مشروعات لتوزيع الأرض عليهم، وبدلاً من دعم حياة العمال ودعم تنمية البرجوازية الصناعية، يتم التوجه نحو قضايا فرعية تفجر الحياة السياسية.
إن الحزب المعارض هنا لابد أن يكشف وجهه الطبقي لأنه في موقع القرار الأن، ولابد أن ينحاز، لكنه لا يكشف مثل هذا الوجه، بل يتعمد الغموض، وجر الحياة السياسية نحو جوانب تأزيمية.
ويجد المذهبيون السياسيون عموماً أنفسهم في مازق تاريخي فإذا أرادوا (الإصلاح) لابد أن ينحازوا إلى العمال والفلاحين، وهذا الانحياز يفجر التنظيم من الداخل. لأنهم سيكونون بين البرجوازية أو العمال، ولهذا لن يغدوا أغلبية برلمانية في أي يوم. ولأجل الحفاظ على هذا الموقف الغامض المتذبذب، وتأييد الجمهور معاً، لابد من افتعال معارك جانبية.
يقوم (الإصلاح) العربي الجديد في حمى الأصلاح الغربي، أي هو نتاج السياسة الأمريكية، التي تشكلها المؤسسات الاقتصادية الأمريكية الكبرى لتوسيع الأسواق، وهي مرحلة عولمية في الكوكب الأرضي، تعيش فيها المؤسسات السياسية الجديدة التي جرى (إصلاحها) على البناء القديم نفسه، فلا تعترف البرجوازية الأمريكية وهي تسوق مشروعاتها السياسية بتاريخها السياسي النهضوي السابق، أي أن تعالج أولاً مسألة الأنظمة التقليدية بدلاً من القفز نحو مرحلة عليا غير ممهد لها. فهذا يخلق الاضطراب على الأصعدة كافة، وهم يعترفون بظهور مرحلة فوضى، لكنها فوضى ستكون في الخريطة العربية الإسلامية.
فالقوى العربية التقليدية سواء التي تحكم أجهزة الدول أو التي تتحكم في عقول الجمهور ستتصارع على السلطات، دون أن تمتلك كلها برنامجاً تحديثياً. والنتيجة كما رأينا هي انتقال الفوضى من بلد إلى آخر. ويعتقد المسئولون الأمريكيون أنهم قادرون على ضبط وتوجيه هذه العملية. لكن كما رأينا من التجارب أن الفوضى تحل في أي بلد مع تطبيق وصفة (الإصلاح) هذه، ولكن حين تتعمم هذه العملية وتتشابك التجارب وتتداخل الصراعات الوطنية والإقليمية فإن الفوضى ستكون عامة.
إن القوى التقليدية العربية والإسلامية التي دُفعت إلى لتغيرات لا تملك قواعد اقتصادية موضوعية للانتقال إلى الحداثة والديمقراطية، أي لم تظهر برجوازيات صناعية تقود الجمهور المشتت المتخلف، وتشكل ثقافة نهضوية ديمقراطية، وهو أمر تمنعه القوى الحاكمة التي تتصرف في الملكية العامة بفساد، بل تظهر قوى تقليدية مضادة للدول تعود بالمسار إلى الوراء، وتحدث فوضى اجتماعية.
وهو أمر يتوافق كذلك مع الشركات الأمريكية الكبرى التي تريد الأسواق والمواد الخام، وتعارض وجود برجوازيات صناعية عربية قوية بطبيعة الحال.
وإذا كانت القوى التقليدية العربية كلها تعبر عن عوالم الأغنياء الكبار المسيطرين، المتصارعين، لكن كل هذه القوى كذلك تزعم أنها تعبر عن العمال والفقراء ايضاً! وهي ترفض التخلي عن هذه المتاجرة بالأوطان والأديان.
وهكذا يغدو (الإصلاح الأمريكي) عمليات تجريبية، وانتقائية، وانتهازية، وهو أمر عائد إلى الجذور الاجتماعية لهذه القوى السياسية الأمريكية الحاكمة، فهي لا تستطيع أن تكرس إلا مصالحها، ولكن إذا كان لنا خيط مفيد من هذه السياسة فلا ضرر من الاستفادة منه ومعارضة جوانبه المحدودة.
إن التغيير لا يكون إلا بجهد القوى السياسية والاجتماعية العربية والإسلامية، عبر الانسحاب من التمثيل المذهبي إلى التمثيل الطبقي، ومن الهويات ما فوق الوطنية إلى الهويات الوطنية، ومن ضرورة تشكيل تحالفات نهضوية ديمقراطية تتوجه لدعم الرأسمال الصناعي سواء أكان قطاعاً عاماً أم صناعات خاصة، وتحسين حياة المنتجين، وأن تقف القوى الاجتماعية حسب مضمون طبقي محدد، وهو لا يمنع التعاون المشترك.
وهذه السياسة المتدرجة تستهدف السيطرة على المال العام وتوجيهه لتطوير القوى المنتجة وتغيير ظروف الناس، ومن هنا لا بد من البرنامج التعاوني التحويلي داخل البرلمانات لمثل هذه السياسة، وهذه تحتاج في الواقع إلى سنوات كثيرة بل عقود.
إن تشكل سياسة ذات توجهات اجتماعية مختلفة هو أمر جوهري، ولكن لابد من رموز وقوى تنحاز الى الأغلبية العاملة والفقيرة، وتجذب قوى عديدة لخط تحول يطور الملكية العامة باتجاه الناس، دون أن يحجر على الحريات الاقتصادية والسياسية.
التقدميون يتغيرون: كتب ـ عبدالله خليفة
هناك أناسٌ يريدون من التقدميين البحرينيين أو العرب بشكل عام، إلا يتغيروا وأن يبقوا في مواقفهم القديمة مؤيدين للاشتراكية السوفيتية وغيرها من الصيغ، ليثبتوا لدى هؤلاء نزاهتهم وصدقهم التاريخي!
ولكن قد جرت عمليات تاريخية كبرى فى القرن الماضي جعلت الكثير من مفاهيم التحول السياسي تتبدل كثيراً، فقد اتضحت محدودية الفهم للاشتراكية، الذي صاغته تجربة التنمية المتخلفة في البلدان الشرقية، واستحالة تشكيل تجارب اشتراكية في بلدان ضعيفة التطور، وقواها الإنتاجية شديدة التخلف، ومع ذلك فتجارب (رأسماليات الدول المركزية) التى جرت في روسيا والصين وأوربا الشرقية، قامت بعمل تاريخي مذهل، فعبر نصف قرن تمكنت من إحداث تقدم هائل، ولكن أداة الدولة التي تقوم بمثل هذه التحولات الكبيرة، لها أخطاء خطيرة كذلك في غياب الديمقراطية وأحداث بيروقراطية معيقة للتنمية المستمرة وفاسدة!
وهكذا جرى تعديل لفهم الاشتراكية وليس التخلي النهائي عنها، وتناضل الأحزاب التقدمية في العديد من البلدان الشرقية للجمع بين الديمقراطية وبين توجيه ملكية الدولة إلى خدمة الجمهور العامل والشعب عموماً، مع تشجيع القطاعات الخاصة على خدمة خطط التنمية.
ولهذا لا تغدو الاشتراكية ملغاةٍ ولكن مضمرة، ومحددة في عملية تاريخية طويلة، تخضع مراحل تحقيقها لإرادة الناخبين وتطور الاقتصاد الوطني في كل بلد، وكذلك تخضع للتعاون والصراع مع القطاعات الرأسمالية التي تشارك في السلطة أو تنتزعها كلية من أيدي أحزاب اليسار، وتقدم برامجها الخاصة برؤيتها، وهكذا يقوم اليسار واليمين بإدارة دفة الدولة كل حسب توجهه ووصوله إلى البرلمان، والشعب يحكم على أداء كلٍ منهما، ولهذا يقوم كل منهما بتطوير قواعد الإنتاج، والاقتصاد، من منطلقاته الاجتماعية ولخدمة القوى الاجتماعية الأقرب إليه، وفى هذا عملية ديناميكية تراكم ما هو إيجابي، ولكن التناقض موجود بين اتجاه يركز على الوقوف مع رأس المال واتجاه يقف مع ملكية الدولة العامة وخدمة أغلبية الجمهور العامل!
وحتى الآن الدول العربية تعجز عن تشكيل مثل هذه التجربة لكونها تعيش مرحلة ما قبل رأسمالية لم تتخلص من عوائقها، ولهذا حين يناضل اليساريون والتقدميون مع نمو الرأسمالية في الدول العربية التقليدية، ليس ذلك تناقضاً مع توجهم العام، ولكن مثل هذا النضال وتحقق دول رأسمالية حديثة وعلمانية وديمقراطية، هو الذي يقربهم من المستوى العالمي المتطور، مستوى الصراع الحضاري والسلمي بين اليمين واليسار!
ولهذا فإن برامج الثورة الروسية في تشكيل تجربة اشتراكية عظمى مزيلة للرأسمالية، عنى عملياً بغض النظر عن الأقوال، تشكيل رأسمالية ولكن بأدوات حكومية شاملة، ومثل هذه الرأسمالية كانت أقرب للطبقات الشعبية، بسبب جعلها التحول المزيل للإقطاع والتخلف، لخدمة هذه الطبقات في التعليم والسكن وغيرها من الخدمات، كما يجعل قدراتها على مقاومة الاستغلال أكبر.
ومع ذلك فقوانين الرأسمالية كنظام عالمي واحدة، فالرأسماليون الذين طردوا عادوا من خلال أجهزة الدولة التى فسدت بسبب احتكار السلطة، وظهروا بشكل أسواً من رأسماليي الغرب، لأن الرأسمالية الغربية تمت عبر عدة قرون من التطور الاجتماعي المتدرج والشامل، وهكذا استطاعت قوى الإنتاج أن تنمو بشكل هائل واقوى من الرأسمالية الحكومية الشرقية، وأن تسبقها وتدمر حواجزها الاقتصادية وتخترق أسواقها!
ولهذا نحن أمام تجارب تاريخية كبرى لا تفيد فيها الأكليشيهات والمعلبات المنتهية الصلاحية، ولابد أن تستفيد النظرية التقدمية العربية من تجارب الشعوب، وتقدم مقاربات أكثر دقة وفهماً لواقعها وللعالم، وهذا أمر ينعكس على تبدل مواقفها من قضايا كثيرة كالتحالفات والثقافة والدين والسلطة الخ..
March 5, 2024
قصة ومسرحية الأطفال عند خلف أحمد خلف : كتب ـ عبدالله خليفة

قصة ومسرحية الأطفال عند خلف احمد خلف:
تجسد قضايا كبيرة بثيمات فنية بسيطة وواضحة
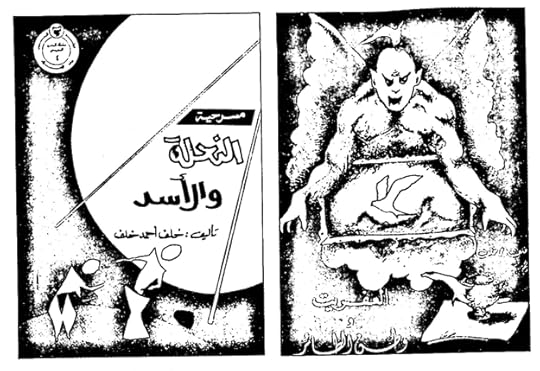
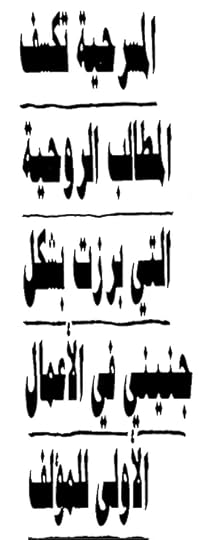
تتنوع اعمال الكاتب خلف احمد خلف الموجهة الى الأطفال، وقد بدأت قصصا قصيرة مثل، «اللعبة»، و«اجمل من قوس قزح». وتطورت عبر أنواع أدبية أكثر اتساعاً كمسرحيات «العفريت» و«وطن الطائر». و«النحلة والأسد». وتتجه هذه الأعمال القصصية والمسرحية الى مناقشة وبلورة قضايا محورية كبيرة، بأسلوب تصويري درامي، يعتمد البساطة والسهولة، رغم تناوله مشكلات روحية وسياسية هامة.
في قصته المبكرتين «اللعبة»، و«اجمل من قوس قزح» سنة 1979، نجد صياغة أولية لقصة طفل مبكر، لم تقع بعد على موضوعاتها الهامة. لكن في قصته نجد الشخصية المحورية هو الطفل المشاكس سلمان الذي يتعلم فن الصداقة مع عصفور، وتتضح السمات الاساسية لفن قصة الطفل عند خلف حيث سلاسة اللغة وبساطتها، والموضوعات القريبة من الحياة اليومية للطفل.
وكمثال على ذلك، قصة «الرسالة العجيبة» – مجموعة قصصية للأطفال اصدار مشترك – نجد الشخصية المحورية هي طفل كذلك، اسمه محمد، يصيغ رسالة عجيبة الى والديه. والرسالة هي محور الحدث القصصي. فقد اتفق محمد مع والده على أن يقوم بجمع نصف ثمن أي شيء مفيد يريده من مصروفه اليومي، ليكمل والده النصف الآخر. وحين راى دراجة جميلة ذات ثمن مرتفع، وهو عاجز عن توفير نصف ثمنها من مصروفه، الذي يريد أن يلهو به أيضا، قرر أن يكتب الرسالة.
إن توجه الصبى ذي الاثنى عشر عاماً الى كتابة رسالة يذكر فيها أبويه بما انجزه من اعمال بسيطة في البيت، كحمل شقيقه الصغير، وشراء الخبز للبيت ومساعدة أمه في تنظيف المنزل، ويطالب ذويه بأجور محددة على اعماله، هو اقرب الى انفجار. فالرسالة الفكاهية تتحول شظية تصيب العائلة في الصميم. ويرد عليه أبوه برسالة اخرى يذكره فيها بأعمال الوالدين تجاهه، دون أن يطلب مالاً عليها. وهنا يحس الصبي بخطاه.
صياغة الحكاية – الحدث، بهذه الصورة، تستهدف التوغل إلى قضايا أخلاقية حاسمة. إنها تنمو فوق جسم الحدث اليرمي العادي، لكنها تتوجه الى اعماقه الدفينة. إن الصبي مدفوع بروح أنانية نفعية يكتب الرسالة العجيبة، متذكراً كل جهد قام به، حتى لو كان تنظيفاً للمنزل في إحدى ساعات الأسبوع، لقد تحولت مصلحته وأناه الى محور للبيت، وللعالم فيما بعد – إذا كبر – وغابت جهود أقرب الناس إليه، وفي سبيل هذه المصلحة الذاتية، يصيغ الرسالة المؤدبة، المهذبة، مستغلا معرفته بأساسيات الحساب، ناسيا أساسيات الأخلاق.
إن تحويل الحدث العادي الى حدث أخلاقي هام، لا يتم عبر الارشاد المباشر، بل من خلال جسد الحكاية المتنامي المشوق.
ويعتمد الكاتب على لغة سهلة، معبرة، تطور الحدث وترسم الشخصيات بلا تكلف. (فكر محمد كثيراً، ثم توصل إلى فكرة رائعة ، قام من فراشه في منتصف الليل، واخرج ورقة وقلما وبدا يكتب).
هذه اللغة السهلة، الدقيقة، تواكب وعي الطفل في هذه المرحلة، لكنها تنزع الى التوغل الى القضايا المتوترة الدرامية، لتعطى دلالاتها التربوية.
لقد أخذت هذه اللغة تتوسع درامياً في مسرحيات خلف المقدمة للأطفال. وفي …
[فراغ كبير لا يمكن ترميمه المحرر]
… العرب، دمشق، سنة 1983 – يعتمد المؤلف ذات البساطة، والاعتماد على الحكاية الواقعية، لكي يتجه إلى القضية الأساسية، الروحية – الفكرية، محور العمل الغني.
فالطفل صلاح كان مصابا بملل وسأم في إحدى الليالي، ويود أن يتسلى بأي شيء. إن وجوده من الناحية الفنية التشكيلية سيكون زائداً، فهو أشبه بمتفرج كبقية المتفرجين. أما الشخصية الطفلية المحورية فسوف يظهر لاحقاً.
كما أنه لا توجد صلة حدثية – مضمونية، بين الشخصيتين، سنرى ان الاولى هو المتفرج، والاخرى هي «البطل»..
كذلك تنبثق شخصيتان ثانويتان تلعبان دورين مختلفين. فالأول هو «الرجل – الطبل»، وهوعبارة عن طبل يدق ويغني طوال الوقت. يضع على عقله قفلا ولا يريد ان يفكر، والرجل الكتاب هو كتاب يمشي مفتوحاً على قصة مصباح علاء الدين.
هذه الثنائية بين البطل الأجوف الصائح ابداً، والكتاب المسلي الممتع المفكر، تتحول دراميا الى شخصيتين متصارعتين، إحداهما تظل ساخرة وتدق نفسها وتصيح في كل مقطع، معبرة عن الفراغ، ولكن تعطي العرض المسرحي فكاهة وتسلية. والشخصية الأخرى جادة ومفكرة وتعرض قصة علاء الدين ومصباحه.
وتنتزع شخصيتا البطل والكتاب وصراعهما، مهما كان طريفا في بعض المواقع، الحيز الذي كان لابد أن يتكرس لقصة علاء الدين. فتعدد الأبطال الثانويين، كان يزحم البطل المركزي وقضيته التي ستعرض لأشكالية فنية.
حين يظهر علاء الدين، نجده خلافاً لصلاح، ابن عائلة فقيرة معدمة يبحث عن حلم لتجاوز عالمه الضيق. لم يكن استمرارية «لصلاح» أو تطويراً ما لشخصيته. لكنه أيضا يثقل بتفاصيل أخرى. كوجوده في المدرسة مع التلاميذ الذين يتحاورون عن مصباح علاء الدين، وهل هو ممكن أم لا، ثم يسألون المدرس المتردد.. (الذي يعكس تردد المؤلف حول موضوع المصباح والعفريت).
إن علاء الدين يجد المصباح فعلا، ولكن في الحلم. ويظهر العفريت لكنه عفريت خائب غير قادر على تنفيذ أحلامه، فحين يحضر له ماندة طعام، لا يستقر طعامها في البطن ساعة واحدة، كما تذوب السيارة التي يحضرها بسبب اشعة الشمس المحرقة والساحر يصير قزماً في الحياة العصرية ذات الآلات والاختراعات.
هل كان الاتجاه الى موضوع العفريت ناجحاً أم أن الطريقة الواقعية التبسيطية حجعت وصغرت من الموضوع الفنتازي الجميل؟
إن بؤرة المسرحية الدرامية – حدث التقابل بين علاء والساحر- كانت مضغوطة ومخنوقة بكل التفاصيل الواقعية اليومية، ولم تعط حقها من التفجير الفني الإبداعي.
كما أن الثيمة الأساسية في الحكاية التراثية، وهي القوى الخارقة الممنوحة للفقير المضطهد، والتي ظهرت في التماعة سريعة في المسرحية، غابت تماماً، لتحل مكانها ثيمة اخرى هى فقدان اهمية السحر في العصر الحديث. وهي تقيم موضوعا مختلفاً عن الذي تشكلت الحكاية على أساسه.
إن تعدد الشخصيات الثانوية، وتأخر ظهور الشخصية المركزية، وتيه الموضوع الرئيسي، وعدم غربلة جوهر الحكاية التراثية. يجعل مسرحية «العفريت» تجربة اولى لصياغة مسرحية طفليه متبلورة.
وهذا ما حققه خلف أحمد خلف في تجارب مسرحية تالية، تماسك فيها البناء الفني بشخصياته وأحداثه ودلالاته.
وهذه الطريقة في التعبير والتجسيد سنجدها بوضوح في مسرحية «النحلة والأسد».
في توجيهات المسرحية المخصصة لمؤلف الأغنية المطلوبة في المشهد الأول يريد الكاتب من المؤلف أن تصاغ كلمات الأغنية:
[بأسلوب مرح، وببساطة في الصورة، قريبة من مقدرة الطفل حتى يتفاعلوا معها ويشاركوا في انشادها].
وهذا هو أسلوب الكاتب، بساطة في الأسلوب والصورة. والاقتراب من مدركات الأطفال. لكن هذه السهولة لا تعني التسطيح، فمؤلف المسرحية، كما هو خطه في عمله الإبداعي، يتجه الى القضايا الجوهرية الهامة في الحياة. كما لو أن الأطفال مسئولون، مثل الكبار، عن مصائر عالمهم وأمتهم. فخلف يختار هنا قضية شائكة هي مشكلة السلطة وأهمية العمل..
ركز المؤلف هنا بنية المسرحية وأطراف صراعها، حيث بدت مجسدة، واضحة، فاعلة، أمامنا. ليس هناك راو، وتعقيبات تخلخل وتوقف تدفق الحدث الصراعي المنهمر، والموقف واضح، والقاعة جزء من الخشبة.
الشخصية الرئيسية الأولى هي الأسد الكسول المسيطر على الغابة، وتبدو مهمته الاساسية هي الأكل والنوم واحتقار عمل الحيوانات.
إن الكوميديا جزء من لعبة المؤلف لأحداث التناغم في البنية الفنية. وقد رأينا هذا السياق عبر شخصية الرجل – الطبل في «العفريت». وفي مسرحية «النحلة والأسد» يحول شخصيتي الاسد – الثعلب، الى ثناني كوميدى طريف، عبر استغلال كسل وغباء الأسد، وذكاء وجبن الثعلب، ويشكل ارستقراطية حيوانية كسولة تلتف حول الأسد.
وحين يطلب الأسد من الحيوانات الصمت والكف عن الغناء المزعج والناقد لكسله وترفه، يصمت الجميع، ما عدا النحلة التي تبدأ المقاومة ضده.
والمسرحية تجسد، منذ البداية، الفريقين المتصارعين، الأسد وجماعته الخاملة من جهة، والنحلة وجماعتها العاملة المنتجة، من جهة أخرى .
ويتضح هدف المسرحية منذ بدء الصراع، عبر قول النحلة، إنها تريد الحيوانات:
[أن تكون حرة.. وهي التي تعمل وتنفع الناس.. بينما الأسد وجماعة الأشرار.. خاملون.. يعيشون على حساب الآخرين]..
وسرعان ما تنتقل النحلة الى المعركة، بلا تردد أو خوف، وتوجه النداءات الملتهبة الى الحيوانات برفض طاعة الأسد، وعدم الكف عن أغنيات العمل. لكن الحيوانات الخائفة تهاب الأسد العملاق، رغم الشكل الكوميدي الذي ظهر به. فلا تصاب النحلة بالإحباط، وتدعو الأسد لمبارزة ثنانية، فيقبل ضاحكاً مستهزئاً. وتتحول المبارزة إلى لعبة طفلية، يستغلها المؤلف لتحويل قاعة العرض الى مباراة مرحة ومشاركة من قبل أطفال الخشبة والقاعة، عبر حساب عدد الضربات الموجهة لكل طرف، وتأييد الطرف العادل.
وتدو جزئيات المسرحية الفنية متآلفة بشكل عضوي، بالشخصيات الرئيسية القليلة تتصارع في الحدث المضغوط الفكاهي – النقدي، وتنساب ببساطة اللغة وسهولة الصور الى عمق الفكرة، وتتوافق البهجة التي يخلقها العرض مع الأحداث الايجابية المطروحة.
وتتكشف، في هذه المسرحية، أكثر من غيرها المطالب الروحية التى برزت بشكل جنيني، في الأعمال الأولى، فالمشكلات الكلية راحت تزيح القضايا الجزئية الهامشية المحدودة، وصارت القضية المحورية هنا هي الحرية والعمل المنتج، فتركزت وتكثفت البنية الفنية التي كانت مفككة فى «العفريت»، وظهرت شخصيات فعالة مغيرة للواقع. لكن لم تزل الشخصيات منمطة، يغلب عليها العام، فتحوي في أعماقها المشكلات الاجتماعية دون خصوصية ذاتية.
إن الوعي التنويري يصل هنا الى مداه في أدب الأطفال البحريني، فتطرح القضايا الجوهرية للتطور، وتغدو هواجس المجتمع الأساسية مجسدة، فتنمو المفردات الفنية من حبكة ـ شخصيات ـ أحداث ـ لغة، عبر ذلك الاستيعاب للواقع، وفي إطار البساطة الواضحة.
March 3, 2024
مناضلون بلا قواعد: كتب ـ عبدالله خليفة
تتشكل الجماعاتُ الديمقراطيةُ والماركسية فوق الحماسة واللغة الاستيرادية الفكرية القادمة من مناطق متطورة إلى مناطق أقل تطوراً. مثلما غذت توده اليسارَ البحريني في مرحلةٍ سابقة.
لقد تشكلت فوق مهمات التحرر الوطني المهمة والمطروحة بقوة لكن تعاليم لينين أمحتْ الفوارقَ بين مرحلةِ التحرر الوطني وبناء الاشتراكية.
لقد أجهضتْ عدةَ أسسٍ جوهريةٍ لنمو التيارات الديمقراطية الحديثة، كالارتكاز على القومية العربية كأداةٍ رئيسية للتحرر الوطني في المنطقة، وعدم تطوير الدين كما هو مُنتجٌ نضالي عقلاني، وألغتْ التحالفَ مع الفئاتِ الوسطى لتشكيل مجتمع رأسمالي ديمقراطي تحديثي علماني المؤسسات السياسية، وتصعيد حضور الطبقات الشعبية في السياسة والتعليم والثقافة وعدم جرها لمغامراتٍ سياسية فوق قدراتها الاجتماعية والفكرية.
فما هو مركزي في هذه التيارات هو تصعيد مثقف محوري قيادي يكون على هيئةِ لينين وعبر الاعتمادِ على المقاطع الصغيرة المفتقدة للدراساتِ التي تتحولُ لمنشوراتٍ ملتهبة، وهو ما يؤسسُ ضحالةً في الوعي متجذرة، وتبسيطاً لظاهراتِ النضال، كذلك تتضاءل الديمقراطيةُ وتسودُ البيروقراطيةُ الحزبيةُ بدعوى السرية، لكونها لا تستطيع أن تشكلَ قيادات جماعية ولا هيئات ديمقراطية سواءً من خلال نسيجِها العامي الشمولي، أو من حيث اعتمادها على تنظيماتٍ غيرِ علنيةٍ لا تستطيعُ القيامَ بهذه الأسس الديمقراطية، فيعتمدُ الأمينُ العامُ على نفسه أو على مجموعة صغيرة تفتقدُ على مرور السنين العلاقة بالجمهور وبالنظرية.
إرتكازُ الجماعات هذه على (اللينينية) يعبرُ عن الارتكاز على رأسماليةِ دولةٍ أُقيمتْ على أسسِ المغامرةِ والدكتاتورية والانتقائية النظرية، حيث يقومُ الحزبُ بالاعتماد على ذاتهِ من خلالِ شكلٍ تحريضي دائمٍ لتأجيج الثورة، ويرتكزُ على تلك الأسس، فنموذجُ الأمين العام المؤسسِ الروسي سيكونُ متجذراً في الأمين العام المؤسس الوطني، ويجري استخدام التكتيكات نفسها التي ظهرتْ لإنتاجِ الثورة البلشفية هناك.
يمكن الانطلاق من البذور الوطنية المحلية من نضالٍ وجماعات لتغلغل الحزب، وتُلغى الدراساتُ الموضوعيةُ للبناءاتِ الاجتماعية في كلِ دولة، حيث ينخرطُ الحزبُ فيما هو يومي نقدي تهييجي، وتُعلى الإرادة الذاتية بشكل نضالي حماسي خلاق حتى تتجاوز القوانين الموضوعية، حيث إن القوانين الموضوعية للتشكيلة الإقطاعية مرفوضة، ويجري دمجها بالتشكيلة الرأسمالية، لتُضربانِ معاً عبر تلك الإرادة العالية المضحية المتآكلة على مدى الزمان الصعب القادم.
جوهر اللينينية يعتمدُ على حرق المراحل لتغدو التحالفات غير مدروسةٍ على الأسسِ الموضوعية لصراع وتعاون الطبقات، فالاشتراكيةُ تصيرُ هدفاً غير مرئي، وما التحرر الوطني سوى واجهة له، ويمكن للجبهة القومية في اليمن الجنوبي أن تتحول بين كارثة وأخرى إلى حزبٍ إشتراكي يخوض مغامرات رهيبة فاشلة.
لهذا وجدنا أن مُصدّر الفكرةِ حزب توده الإيراني هو بذاته لا يعرف إدارةَ النضال في بلده، ويؤدي لدكتاتوريتين مَلكية ثم طائفية قومية تضعنا جميعاً في المنطقةِ في مرحلة الخطر.
مثلما أن الحزب في العراق يعتمد التهييج المتنامي لسحق المَلكية والاستعمار مع غياب التحالفات بين الطبقة العاملة والبرجوازية وتصعيد الديمقراطية بشكل دائب وإصلاحي طويل، ثم نجدُ أنفسَنا في حروبٍ ضارية متتالية حتى يغدو العراق خريطةً فسيفسائية ملتهبة أو محروقة.
المجموعاتُ المتعددةُ في هذه البلدان رغم تضاريس شعوبها المختلفة استعملت روشتةً طبيةً واحدة، المكتوب فيها تلك الخطوط العريضة للطبيب السوفيتي ذي الشهادة غير الدقيقة.
تغييبُ القوميةِ والإسلام وظروف كل بلد، تعبيرٌ عن عدم أهميتها، فإلارادةُ الثوريةُ تغيرُ الخرائط، ويُحضر اسم البروليتاريا ليختصر كلَّ الظروف، وتندفع الحماسة وتدفع العامة البسيطة الوعي المشحونة بالشعارات والأيديولوجيا المسطحة، لتسود الشوارع، لكن لا تحدث التغييرات على النسق الأصلي المستورد. لكون النسق الأصلي بُني على مغامرةٍ ظهرتْ بسبب كوارث الحرب العالمية الأولى وانهيار الدولة الروسية ومعاناة الجماهير بعد قتل الملايين، فيما الدول الوطنية الجديدة تنمو في ظروف مغايرة.
كانت سياساتُ الجبهاتِ الوطنية والتراكم الديمقراطي الطويل الأمد ونشر التحديث، وتطوير أحوال الجمهور ونقله من الأمية والخرافة والفقر هي المطلوبة في هذه المجتمعات المتخلفة التي هي بحاجة إلى تطورات أساسية قبل أن يُزج بها في تحولات عالمية من دون جذور، وهي أمورٌ سوف تواصلها الجماعاتُ الدينية معتمدةً هذه المرة ليس على نموذج مستقبلي من الفضاء بل على نموذجٍ مؤدلج متخيل محافظ من الماضي البعيد، لكن هدم الأسس الموضوعية للتطور الديمقراطي الأولي ساعد هذه القوى الدينية على الصعود متوهمةً أنها هي التي حققت ذلك الخرابَ الاجتماعي السابق الذي تؤدلجه باعتباره انتصارا على قوى الكفر والتغريب.
في كلا الجانبين يغيبُ التأسيسُ الموضوعي لتطور البلدان العربية والإسلامية، التعاوني التحالفي الاختلافي لتصعيد قوى النهضة، والتقدم، وفي حين وجد الديمقراطيون والماركسيون أنفسهم بلا جمهور يظن الدينيون أنهم حققوا جمهوراً، وهو ليس بجمهورِ تحولٍ فهو ذات الجمهور السابق ولكن اختلفت أصباغُهُ الخارجية ولكن المضمون الشمولي المحافظ الذكوري الحماسي الشعاري المذهبي الغائر هو نفسه وأن كان الأخير قد برز بحدة.
العودةُ إلى مهمات التوحيد والنهضة والتنوير والإصلاحات الجزئية المتصاعدة والعقلانية مهمة لتجنب انهيار مرحلة سابقة وانهيار مرحلة جديدة متجمعتين على رؤوس الناس. ولابد من تعاون كل التيارات الحديثة الماركسية والإسلامية والقومية لكي لا نكررَ أخطاءَ الماضي.
February 29, 2024
توسع الفلسطينيين الإنساني : كتب ـ عبدالله خليفة
خبتْ علاقاتُ حركةِ النضال الفسطينية بالوطن العربي في العقود الأخيرة، حيث اتجهتْ قيادةُ هذا النضال نحو الارتباط ببعض الأنظمة العربية التي كانت تنحدرُ نحو الشمولية وأزماتها من قمعٍ وحروب داخلية وأخيراً توُجت بثورات عارمة.
كانت قيادة النضال الفلسطيني تنقسمُ على نفسها، مثل عجز قيادات الدول العربية عن التطور نحو الديمقراطية، وعدم القدرة على توجيه الأنظمة نحو الرأسمالية الحديثة، فتفاقمتْ أزمةُ الأمةِ العربية في العديد من دولها، وبدا شكلُ الانقسامِ في القمة بين ليبراليةٍ محدودةٍ زائفة وبين مذهبيةٍ دينيةٍ محافظة تعبيراً عن خنقِ الطبقاتِ الوسطى وعن عدمِ إتاحةِ الفرصة لدورها الطليعي.
ويحاولُ القادةُ الفلسطينيون الخروجَ من ذلك بشكل تجريبي، ويشكلُ ذلك المصالحُ القريبةُ الرديئة، والظروفُ السياسيةُ والجغرافية، فيعطي البحرُ الأبيضُ المتوسط والقوةُ الديمقراطيةُ الغربية المتجذرةُ فيه فرصةً صغيرةً للعمل من دون قبضات الرأسماليات الحكومية الشرقية الشمولية. لكن لاتزال أموال هذه الرأسماليات هي التي تغذي السياسةَ الفلسطينية، وبالتالي تجبرها على المحافظة.
لقد أدى الارتباط بهذه الشموليات إلى تمزق الشعب الفلسطيني، وعدم قدرته على تطوير ديمقراطيته وعلمانيته الداخلية، وعدم مجابهته التحديثية الأممية لإسرائيل، ولهذا أصبح النضالُ الفلسطيني مهجوراً بشكل عربي، وتجري كلُ الفظائع ولا يتحركُ العربُ الذين كانوا في وحدةٍ نضاليةٍ حميمة مع الفلسطينيين.
ولهذا يغدو توجههم نحو أوروبا قارة الديمقراطية المؤسِّسة، واستثمار التجربة التركية المتجهة نحو الديمقراطية، بداية لفهم ما يجري في العالم بدلاً من الركون في عصر الدول العربية الوسيط.
لكن ذلك يجري كتعبيرهم دائماً بشكل تكتيكي، من أجل تعرية الاضطهاد الإسرائيلي، وهو لا يرتقي بعدُ أن يكون موقفاً أممياً ديمقراطياً، فيتركز على الحصار الذي ينفتح شيئاً فشيئاً خاصة عن طريق مصر.
إن التضحيات المذهلة التي قدمها الأتراك والأوربيون عبر السفر في البحر المسموح والممنوع والرحلات الجوية المغلقة والاعتقالات أوجدت شكلاً من التضامن الإنساني الكبير. وبقي المشهد الأوروبي الإنساني مفتوحاً للمزيد من التقدم كلما استخدمت أساليب نضالية سلمية.
إن النضال العربي القادم والتطورات المذهلة في الأبنية السياسية الاجتماعية ستترك بصماتها على العمل الفلسطيني كذلك.
لكن البؤرة التي ناور عنها الفلسطينيون طويلاً وهي مرتكزهم للتغيير هي البشر الإسرائيليون، هؤلاء الذين عاشوا مكانهم، وأزاحوهم ويشاركونهم في مصيرهم، صراعاً وتعاوناً.
بؤرتهم هي هؤلاء، وحين تلغي القوى المسيطرة في إسرائيل موقعاً أنشأه الشباب الفلسطينيون في الفيس بوك يقصّ تاريخَ القضية وانضم إليه أكثر من سبعين ألفا من الناس في الغرب، يؤكد ذلك كيف تؤدي الوسائل الحديثة والعلاقات الانسانية المتطورة الآن دورها في تقزيم التطرف الإسرائيلي وإعادته إلى حجمه الطبيعي.
ولو طُبقت هذه الوسائل على الإسرائيليين ذاتهم لوجدنا توسعاً للنضال المشترك ولهزيمة القوى العسكرية والدينية المتطرفة



