عبـــــــدالله خلــــــــيفة's Blog: https://isaalbuflasablog.wordpress.com , page 15
September 14, 2024
15 سبتمبر: اليوم العالمي للديمقراطية: كتب ـ عبدالله خليفة
قيادة الديمقراطية العالمية
لن يستطيع الانتصار(الديمقراطي) في الولايات المتحدة أن يمثل شيئاً ديمقراطياً عالمياً، إلا بوضع حد لسياسة الحروب التي شـُنت في العالم الثالث والتي كانت بمثابة تتويج لأخطاء السياسة الأمريكية والغربية خلال نصف قرن مضى، وكذلك وضع حد لسياسة رفض الحوار مع بعض الدول المهمة ووضع حد لسباق التسلح العائد بخطورة ورعب على البشرية.
ومن الواضح بأن الطبقة السياسية المسيطرة على إنتاج العلاقة الاستغلالية مع الشعب الأمريكي العامل ومع شعوب العالم الثالث العاملة لمصالح الشركات الغربية، ليست لديها إصلاحات جذرية في ذلك، ولكن هي سياسة إعادة التوازن للسياسة الأمريكية بعد أن وجهها الجمهوريون خلال السنوات السابقة إلى أقصى اليمين.
لقد قامت هذه السياسة على مدى العقود على ضرب مواقع الرأسماليات الكبرى الحكومية في الشرق خاصة الاتحاد السوفيتي، فقامت السياسة الأمريكية بإستنزافه حربياً بشكل سلمي عبر سباق تسلح مخيف أهدر فيه الاتحاد السوفيتي ثروات ضخمة، ثم تم جره إلى حربِ إنهاكٍ ضارية في إفغانستان، تفكك بعدها وتحول إلى دول وأسواق مفتوحة جلبت المليارات للشركات الأمريكية والغربية. وهو ما تقوم به السياسة الأمريكة الراهنة تجاه إيران وسوريا عبر إنهاكمها بسباق تسلح عقيم لا تستطيعان مجاراة الغرب فيه.
وكانت الصين قد رفعت الراية البيضاء ودخلت المشروع الرأسمالي العالمي المفتوح، وبسبب ضخامة أسواقها وعدم إنجرارها لميزانية تسلح كونية استطاعت أن تتقارب مع الدول الرأسمالية الكبرى في الصناعات الاستهلاكية غالباً.
مثلما غدت أوربا الشرقية ساحة مفتوحة لهذه الشركات ولتدفق الأرباح لوراء الأطلسي.
كما رُفع الحظر عن نمو الرأسمالية الحرة الديمقراطية في أمريكا اللاتينية وأُزيحت الأنظمة العسكرية البالغة السؤ في تلك القارة، ولكن دول القارة توجهت لليسار الديمقراطي، وهذا لا يضير السياسة الأمريكية كثيراً، لأن تلك السياسة تقوم بإصلاحاتٍ عميقة في البنى الإقطاعية الزراعية والحكومية البيروقراطية المتخلفة، مما يعني توسع الأسواق للبضائع الأمريكية كذلك.
فيما عدا نموذج فنزويلا الذي يجعل الدولة تقوم بدور مهيمن شمولي وهو نموذج تجاوزه العالمُ شرقاً وغرباً.
كما أن الدول العربية النفطية واصلت دور البقرة الحلوب للصناديق الأمريكية والغربية، غير قادرة على التصنيع والتغيير الاجتماعي العميق الذي يستثمر المداخيل الكبيرة بل هي تتآكل في حروب أمريكا الكثيرة وفي أزماتها كذلك!
إذن كانت التحولات السياسية في أغلبية دول العالم مفيدة للاقتصاد الأمريكي ومع ذلك كله فإن الأزمة الاقتصادية الأمريكية التي أمتدت للعالم بسبب امتداد شبكة الاستنزاف الأمريكية عبرت عن فشل هذه الهيمنة الاقتصادية الكونية.
وهذا بسبب إن عالمية الاقتصاد الأمريكي هي عالمية مكرسة لاقتصادها البذخي الداخلي وللانفاق العسكري الهائل وليس لتوسيع الإنتاجين الوطني والعالمي.
ولا عجب هنا أن تتفوق دولة نامية كالصين في مضمار النمو الاقتصادي وهي لا تمتلك موارد أمريكا وثقلها في الصناعات الثقيلة والتكنولوجية، فقط لأنها كرست مواردها للسوق المنتجة، وليس للبذخ والعسكرة.
لقد أعطاها الاقتصادُ الحكومي إمكانية التخطيط الاقتصادي الوطني الواسع النطاق ولآفاق زمنية كبيرة، والتحكم في الاستهلاك الفردي خاصة، والاستفادة من كافة الطرق الاقتصادية الرأسمالية الحرة والموجهة كذلك.
إذن لن تنفع أمريكا مرة أخرى عمليات إستنزاف موارد الدول الأخرى وجلبها لاقتصادها، كذلك فإن الدول الأخرى شعرت من درس الأزمة الاقتصادية الأخيرة ذات المظهر النقدي، أن الأمور بحاجة إلى تغيير في المركز الكسيطر عالمياً والذي تتقلقل سيطرته اقتصادياً وسياسياً.
وهذا التغيير لن يكون سوى بتوسع مساحات التطور الاقتصادي الحر حقاً في دول العالم الثالث، وتوجهاتها نحو التصنيع، والتحديث التكنولوجي، وزيادة قوى العمالة الوطنية في كل بلد وتعميق تطورها.
لكن وعي القوى الرأسمالية المتحكمة في عالم الاقتصاد سواء في المركز الأمريكي أم في الدول النامية، اتجه فقط لانقاذ حيتان السوق وخلق إندماجات بين البنوك والشركات، مما يوجه الأمور نحو أزمة أكبر لاحقاً، وسوف تتوسع لتصل إلى قطاعات الإنتاج.
فهل سوف تتوجه الإدارة الأمريكية الديمقراطية إلى برامج ديمقراطية على مستوى الداخل الأمريكي وعلى مستوى العالم؟
يُلاحظ بأن برنامج الرئيس الجديد يتوجه لمساعدة الطبقة الوسطى الأمريكية ولعدم التحجر عند مصالح شركات السلاح والنفط الكبرى التي كانت مرساة الإدارة السابقة والتي جعلت السفينة الأمريكية تغوصُ مقدمتـُها بعمق في محيط الأفلاس.
لكن هذه الشركات لها طرق في تحريك الأمور نحو مصالحها، كافتعال معارك بين أمريكا وبعض الدول في العالم الثالث، وتهييج الدول الاشتراكية سابقاً وخاصة روسيا من أجل سباق تسلح جديد مروع ومدمر.
وفي برنامج الرئيس الجديد لا تزال أمريكا هي بؤرة العالم التي يجب أن تتدفق نحوها رؤوسُ الأموال وتتوجه منها البضائعُ الاستهلاكية والعسكرية، وهو ما يجعل الكثير من جذور الأزمة الاقتصادية راسخاً.
ومن الصعوبة أن يقترب الديمقراطيون الأمريكيون من اليسار الأوربي ومن الاشتراكية الديمقراطية العالمية، فقد كانت لهم جذور هائلة في العداء لهما، وحتى الليبرالية تمثل لأقصى اليمين شراً كبيراً، مما يجعل الصراع السياسي العميق والديمقراطي الأوربي بين اليسار واليمين، غير مطروح على جدول أعمال السياسة الأمريكية الداخلية لسنوات عديدة قادمة، ولكنه قادم، ولن يستطيع الحزب الديمقراطي أن يمتنع عن مقاربة الاشتراكية الديمقراطية طويلاً.
ولهذا فإن جدول مجابهة الدول الشرقية غير الديمقراطية تماماً أو الشمولية، أو التوسعية، كروسيا وإيران وسوريا وإسرائيل، سوف يستمر، لتتخلى هذه الدول عن طموحات التوسع، وبضرورة الانحصار في حدودها.
ومع إعلان الرئيس أوباما تنفيذ الدرع الصاروخي في أوربا الشرقية تكون إحدى المواجهات العالمية قد استمرت واستمر إستنزاف الموارد للسلاح.
وهي نقطة سوف تستفيد منها قوى اليمين للعودة، خاصة مع تراجع الجمهوريين ومحاولتهم العمل مع الديمقراطيين.
تعتمد الديمقراطية العالمية توسعها على قوى الرأسماليات المنافسة والشرقية خاصة ومدى استيعابها لدورس تعثر الغرب، ومزاوجتها بين الديمقراطية وتوجيه الدول والقطاعات العامة للاقتصاد، وتطوير وضع الطبقات العاملة معيشة وثقافة حديثة. فسيكون القرنان الراهن والقادم هما قرنا صعود الشرق الجديد.
15 سبتمبر: اليوم العالمي للديمقراطية : كتب ـ عبدالله خليفة
كتب : عبـــــــدالله خلـــــــيفة
ما هي الديمقراطية؟
الديمقراطية الحديثة وبناؤها
الديمقراطية عملية مركبة
الديمقراطية تحولٌ تاريخي
معاني الديمقراطية في الشرق
الديمقراطيةُ طريقٌ واحدٌ
لا ديمقراطية من دون علمانية
الإسلام دين الديمقراطية والعلمانية
ما هي الديمقراطية؟
إن مصطلحات مثل ديمقراطية وقوى ديمقراطية وطنية تحتاج إلى فحص للتأكد من سلامتها.
كلما اتسعت قدراتنا على التفكير الحر كلما زاد نقدنا، وعرضّنا مفاهيم وتورايخ قديمة للنقد، إن هذا يشكل تطوراً في التفكير الحر، ولهذا فإن مصطلحات مثل قوى ديمقراطية تجعلنا نسألُ هل تستطيع القوى الشمولية أن تكون ديمقراطية؟
نتجت القوى السياسية من إقتباس تجارب شمولية عالمية وعربية، فكيف ستأتيها الديمقراطية؟ هل الديمقراطية هي التصويت المرتب؟ وهل هي تقدر القوى الشمولية أن تطور تجربة ملتبسة بين الشمولية الحكومية وبعض الحريات؟
إذا كان يتم ترتيب التصويت لتبقى جماعة مسيطرة على الجماعة ككل، كما أن القائد بقي ثلاثين أو أربعين سنة قائداً وحين يموت يواصل أصحابه نهجه ونفخ مسيرته العظيمة، فترى السياسي العربي دائماً يحكم من قبره؟
(الديمقراطية) الشرقية الشمولية لا تريد أن تكون ديمقراطية غربية، والأحرى أن نقول أنها لا تستطيع ذلك، وهيهات وربما لقرن من الصراع والتجديد والمشكلات!
هناك طبقة وسطى كبيرة حرة، ذات مؤسسات قوية، ورأمسالية الدولة صغيرة تقتصر على المؤسسات العلمية والإشرافية، وليس أن تبتلع الأخضر واليابس كما هو الأمر لدينا. وأن تكون هناك طبقة عاملة موحدة وإنتجتها المصانع الخاصة وليس عمالاً تابعين لشركات حكومية لا تسمح لهم حتى بالدفاع عن مصالحهم الإقتصادية البسيطة.
الشروط كلها مفقودة في التجارب التي يقال أنها تتجه للديمقراطية.
والقوى السياسية تريد تشكل رأسمالية دولة تقوم هي بإدارتها.
هكذا الأمر في التجارب القومية العربية حيث نجد ذروة التجربة هي وجود حكومة شمولية مستولية على الإقتصاد.
وهكذا التجارب الإشتراكية.
إذن كيف ستظهر الديمقراطية من تكوينات كلها لم تجرب الديمقراطية؟
تنظيمات ترتعب من الأفكار الحرة ومن الحراك السياسي الحر داخلها، القواعد لا تعترض ولا تطرح قيادات من داخلها ولا تعرض تاريخ التنظيم للتحليل والدرس والنقد؟
هناك هوامش من هذه العملية في نقد الظواهر الحكومية السيئة، والمطالبة بالتغييرات فيها وفي إدارة البلد، لكن كل هذه تبقى إنتقادات قد يقبل بها وقد لا يسمع بها وقد ترفض.
ليس ثمة سلطة تشريعية قوية.
والتنظيمات لا تستطيع أن تكون مثل هذه السلطة التشريعية القوية، لأسباب التفرد الحكومي الإقتصادي بدرجة أساسية.
لكن لو قامت التنظيمات الدينية بإدارة الإقتصاد هل ستكون هناك ديمقراطية؟
ستظهر هناك قوى مهيمنة على الفوائض الإقتصادية، وستقلل الحريات الإجتماعية، وربما تقوم بقمع كبير للقوى العلمانية والملحدة والغربية المستوردة وللحياة التحديثية البسيطة التي تشكلت بعسر خلال قرن؟!
أما القوى التي تحتضن الحداثة الديمقراطية أي الطبقة الوسطى الحرة ذات المصانع والشركات المستقلة فغير موجودة بإتساع كبير، وحتى الموجود كثير منه مجرد لافتات للشركات الحكومية والرموز الحكومية؟
إذن النسيج كله شمولي مناقض للديمقراطية، والأمور تحتاج لعقود طويلة وأجيال لتؤسس ديمقراطية وطنية!
وقد تركت الحكومة الجماعات المذهبية السياسية في مقدمة المسرح السياسي، وعبر خصامها بالدرجة الأولى، وهي تدير اللعبة السياسية كلها.
وإذا تحرك التجار سوف يشتغلون لمصالحهم ولزيادة فيض العمالة الأجنبية ولرفع القيود عن التجارة وإلغاء قرارات وزارة العمل، وليس فيهم قدرات كبيرة على طرح قضايا الديمقراطية والعلمانية والتحديث!
لقد أدت السيطرات الاقتصادية الطويلة والثروات النفطية إلى بروز القوى العربية البدوية السنية في الجزيرة العربية، لتشكل نهضة تحديثية من خلال رأسماليات الدول التي تخضع للقبائل والأسر الحاكمة والتجار الكبار، والتي يمكن التخفيف من غلوائها التفردية عبر النقد وتعاون الكتل السياسية المختلفة، والتطوير التدريجي للصناعات الخاصة وما يماثلها من مؤسسات تحديثية إقتصادية ومراقبة الملكيات المسماة عامة، وتطوير الحياة الاجتماعية تدريجياً عبر هذه السنين الصبورة.
هذه هي حدود (الديمقراطية) الخليجية وغير ذلك أما إنقلابات تقود لما قادت له في الدول العربية وبتجاربها المعروفة، وأما الإرهاب.
الديمقراطية الحديثة وبناؤها
لا بدَّ من تداخل وتشابك العملية التحولية السياسية مع قوانين الديمقراطية العالمية، فتغدو الأحزاب معبرة عن فئات التجار والحرفيين والعمال والنساء، فينفصل الحزبي عن جماعته المذهبية، ويصيغ عقليته السياسية في ضوء تعبيره عن هذه الفئات وتلك، ويمكن لفئات الحرفيين والتجار والعمال أن تتقارب اجتماعيًا وسياسيًا، وهذا الانفصال ليس قطعيًا وباترًا في الديانة بل هو جزء من ثرائها، وتعبيرها عن مطالب الجماهير على مر التاريخ.
لكن هذا التعبير يأخذ شكلاً حضارياً ليس فيه مساس بالفئات السكانية الأخرى ويأخذ طابعه الإنساني كذلك.
فئات الوسطى الصغيرة يمكن أن تتقارب وتجد مشتركات بينها، والفئات الوسطى الكبيرة تجد حياتها وظروفها تدفعها للتكتل بصفة معينة.
هذه العمليات السياسية الاجتماعية ليست ضد التاريخ الديني بل هي تستقي من خبرة التاريخ العربي الإسلامي وترى التفكك الذي جرى ويجري وتتجاوزه.
إضافة إلى تداخل فئات الشعب وتبلورها سياسياً فهي تغدو مركزة على ما هو معبر عن الواقع الاقتصادي الاجتماعي، فتتلاقى فئات على صعيد الوطن والمنطقة، ولا تغدو النخبة هي المعبرة عن الحزب، وتقطع علاقاته بالفكر والاقتصاد وتجعله محدوداً غير قادر على التطور السياسي المستقبلي.
بطبيعة الحال هذه تحتاج إلى عمليات تنوير وتفكيك سياسي وإعادة بناء ويمكن أن تأخذ جذور التنظيم وتدمجها في العملية المعاصرة.
إذا لم يحدث ذلك فإن التنظيمات المكونة على أساس طائفي هي التي سوف تتغلب وتصعد عملية الصراع بين طائفتين، وتؤدي إلى الشروخ التي حدثت في بلدان أخرى.
ترتبط انتماءات الفئات السياسية الجديدة بتغيير طابع الملكية العامة التي تُحرر وتغدو ملكيات خاصة، أو مباعة على البرلمان، أو مراقبة من داخله وهو الذي يقوم بتوزيع دخولها حسب حاجات الطبقات والفئات ومدى مساهماتها في عمليات الانتاج.
هنا أشكال معينة مرتبطة بالعلمنة والتحديث والديمقراطية حيث تنصب اهتمامات الطبقات والفئات على مصالحها المادية وتبرمجها وتدافع عنها في البرلمان.
هذا يستلزم تغيير الوعي العامي السطحي ووعي المتعلمين الذين لا يتجاوزون هم كذلك هذا المستوى بسبب كسلهم الفكري وعدم تجذرهم في قضايا الفكر والفلسفة والسياسة والتاريخ ورفضهم التحليل وعيشهم على المسلوق إعلاميا والمنتهي الصلاحية.
ولا يمكن تغييره سوى بالصدام معه ونقده وكشف تناقضاته حيث يقوم العلمانيون الديمقراطيون بتحليل الشبكة الصدئة للماضي والحاضر.
في العملية الطويلة التاريخية لتحول الفئات الوسطى لطبقة وسطى وتوجيه الفوائض الكبرى نحو الصناعة وتغيير معيشة القوى المنتجة لتحدث عمليات تفكيك على صعيد المال العام والثقافة والتعليم وتغدو الوظيفة الحكومية مرحلية قصيرة مرهونة بإنجازاتها، ومساءلة من قبل الجهات التي تقود العملية التحولية التاريخية يجري صنع التحول الحقيقي.
بهذا تتوجه البلدان نحو تغيير طابع الذهنية المحافظة الملتصقة بالتراب العتيق والتي ينفصل عنها الأميون ويتدفق عليها المتعلمون والمثقفون، الذين يغادرون انتماءات (الفرجان) والأحياء الضيقة وينتمون إلى أوطان وتجديد مبانيها.
الديمقراطية عملية مركبة
الديمقراطية عملية مركبة معقدة في تاريخ الشرق بل وفي العالم كله، ولكن منطقتنا إختصت بتعقيد طويل للظاهرة حتى بلغت مجموعة من القرون.
حين جاء السيد محمد علي الطباطبائي إلى طهران سنة 1894 ألح على إقامة دستور وتأليف مجلس شورى شعبي، ويقول(كنتُ أذكر هذين الأمرين على المنبر، وكان الشاه ناصر الدين يشتكي مني، ويبعث لي بالرسائل التي تقول بأن إيران غير مستعدة للدستور لحد الآن. لقد كنتُ مبتلي به طالما كان حياً حتى ذهب).
صراع المشروطية أي الدستورية ضد الاستبداد طويل، فكم مرتْ من عقودٍ من بداية القرن التاسع عشر لحد الآن دون أن تتكامل المشروطية التي تجعل الحكمُ المستبد مقيداً؟!
ظهر البرلمان الأول في إيران سنة 1906 وأُزيل بعد سنتين وعادت الحياة صراعاً بين الشمولية والنزعة الدستورية تتقلب عبر العقود دون أن تصل لبر الأمان حتى الآن!
تقوم الحركات الديمقراطية في الشرق عموماً على النخب الصغيرة المحاطة ببحرٍ من التخلف والاستبداد في الطبقات المختلفة، وبين الرجال والنساء، وفي الدين والثقافة، فحين جاء السيد محمد علي الطباطبائي كم كان معه من دعاة الديمقراطية؟ بضع أشخاص، وضده حشود من رجال الدين والقبائل والأسر المتنفذة، وحياة إجتماعية يسودُها الاستبداد، فالشعب ذاته لا يعرف ما هي الحرية وما هي ثقافة الحرية، والرجال مستبدون بالنساء، والنساء يستبددن بالأطفال، والمثقفون إنتهازيون، يعملون مع الدول بوضاعة حتى إذا سمعوا إنفجارات الحرية يطلقها مضحون قلة ورأوا بوادر نصرها وإنتشار وظائفها إندفعوا نحوها عساهم يحصلون على مغانم منها. فإذا إنهارت وجاء حاكمٌ جديدٌ غيرُ الذي قَبل بها، ولم تعجبه هذه(المشروطية) وأقامَ إنقلاباً عبر فرقة أجنبية من الروس قطعتْ رؤوسَ الثوريين وعاد المثقفون للحظائر ولعلع صوتُ الشيخ فضل الله نوري صارخاً:
(إن أصلي المساواة والحرية مخربان لركن القانون الإلهي القويم. إذ أن الإسلامَ يقومُ على العبودية على الحرية. وأحكامهُ ترتكزُ على تفريق النقائض وجمعها لا على المساواة. فما تؤدي إليه المساواةُ هو أن تُحترمَ الفرقةُ الضالة والطائفةُ الإمامية على نهرٍ واحد)!
يقوم المتنورون والحكامُ الطليعيون ودعاةُ التقدم في الشرق بالعمل لنشر الديمقراطية أو الإستجابة لدواعيها لأسبابٍ مختلفة، لكن عبر شروط ذاتية مثل كتابة دساتير كما فعل السيد الطباطبائي وعمل نخبة تروج للدعوة، وإنتهاز مناسبات سياسية وإجتماعية لإطلاق الدعوة والتأثير على الأوضاع وإقناع الحكام على القبول بها، فيتحول المجلس أو البرلمان لجسم سياسي محنط أو جامد غير قادر على الفعل، أو يتمكن من تأدية دوره وسن القوانين لكن السلطات تنقلب عليه.
فليس ثمة شروط موضوعية كبيرة لكي يلعب هذا البرلمان دوره، فالشعبُ أساسُ الحكمِ الديمقراطي متخلف، والديمقراطية هي حكم الشعب؟!
الشعب ليس في مستوى الديمقراطية، فلا يصطف بالطوابير بنفسه، ولا يقرأ برامج المرشحين، ولا يعرفها أو يناقشها إذا تمكن من قراءتها أصلاً.
فيأتي أناسٌ هم الذي يَجلبون الشعب للتصويت، بالخداع أو بالشراء، أو بالدعوة الدينيةِ المُلزمة، وهؤلاء المندوبون من سلطاتٍ دكتاتوريةٍ دينية وسياسية عرفية وإجتماعية ليسوا ديمقراطيين بالضرورة، وليس مطلوباً منهم أن يكونوا حتى مثقفين!
وهنا لن تتصارع قوى ديمقراطية متنافسة بجدارة لفهم أحوال الشعب، ولن تقوم بدرسِ أحوال الشعب لكي تصل لمشكلاته وجذورها وتقدم الحلول وتكسب الأصوات داخل البرلمان من أجل حل مشكلات الشعب!
شعبٌ ليس ذا علاقة بالديمقراطية لا ينتجُ ديمقراطية.
بطبيعة الحال هذا يتطلبُ شعباً على علاقةٍ وطيدة بفهم السياسة وفهم البرامج والأحزاب ويافطاتها الحقيقية والمزيفة وبغياب مثل هذا الشعب فهو يسمح للمستبدين والانتهازيين أن يقطفوا ثمار تعبه من مال وزمن تاريخي، فالديمقراطية هي بلا وكلاء ومقاولي أنفار وباصات تشحن الناس مثل البهائم.
نتائج مثل هذه الوكالة تقعُ على رؤوسِ الشعب نفسه، حين تشتغلُ النخبُ بالتلاعب بمصيره، إنقلاباً وحروباً وفساداً سياسياً طويلاً يقود لليأس من الديمقراطية وحب الدكتاتورية!
كذلك فإن الشعوبَ ليست في حالات مجردة، فبدون الطبقات الحديثة من طبقة وسطى ذات مشروع ديمقراطي تحديثي أو طبقة عاملة ديمقراطية، لا يمكن للشعب أن يكون شعباً حديثاً، يصنع مؤسسات تتصارع بشكل سلمي لتحديد ثمار الاقتصاد كيف تتجه، والفوائض المالية من تخدم من طبقات المجتمع وأية مشروعات تحظى بالأولوية؟
الديمقراطية لعبة سياسية متحضرة، لأجل سلطة قابلة للمداولة، لقوى تعلن هزيمتها بقوة حين تفشل مشروعاتها، وتعددُ هي أخطاءها قبل غيرها، لا تتعكز على عكاكيز المال والدين والخداع، وليست هي لعبة بين قوى دكتاتورية يريد كل منها أن ينقض على الآخر حين تأتيه الفرصة!
الديمقراطية تحولٌ تاريخي
تتشكل الديمقراطية بفضل الفئات الوسطى، وذلك حين تتوجه لاستلام السوق المحلية، وحين ترث ملكيات الدول، وتعيد تشكيل الاقتصاد الحرفي والصناعات الصغيرة إلى صناعة آلية، وتطور مهارات العمال حسب مستوى تطور العصر الصناعي – التقني..
ورغم ضخامة هذه الشروط الاقتصادية فهي تتطلب شروطاً فكرية وسياسية، فبماذا تعبر الدولة الدينية أو المذهبية أليست هي تعبيراً عن العصر السابق على الحداثة والرأسمالية؟
إن المذهبيات السائدة هي مذهبيات محافظة تعبر عن الطبقات فيما قبل الرأسمالية، وتعني وجود مجتمعات مفككة، وغياب السوق والشعب الموحد الخ..
لهذا نجد إن العديد من رجال الدين المنفتحين يشتغلون في تجديد الموقف من البنوك ومن الموقف من العلاقات مع الأمم غير الإسلامية ومن قضايا الحدود، ومن أنواع الحكومات الخ.. وهي كلها محاولات لإنتاج أحكام تعبر عن فئات وسطى تحاول التقريب بين النظام الاجتماعي التقليدي والنظام الحديث كما يتتجسد في الغرب، دون أن تتطابق معه في الأخلاق والدين، دون يستطيع رجال الدين هؤلاء إنتاج نظام إسلامي ديمقراطي، لأن
إن العصر العربي الراهن هو عصر التمهيد للديمقراطية، ولهذا هو يدخل مخاضاً معقداً منجراً إلى صراعات سياسية اغلبها يؤدي إلى تدمير قواه الانتاجية، وبدلاً من أن يكون التحولات السياسية هي تتويج طويل للنمو الاقتصادي وتشكل طبقة وسطى موحدة، تؤدي التحولات السياسية إلى تفتتيت كل مجتمع عربي.
فقد لعبت الدولة المركزية المسيطرة على المجتمع ذات التوجه الديني الشمولي عامل السيطرة على تكوين البلد المفتت، ولكن تطور العملية الديمقراطية يقود إلى إزاحة سيطرة الدولة على الاقتصاد، وهذا يؤدي إلى دخول المجتمع طور التفكك، كما يجري في العراق، والسودان، وفلسطين وكما جرى في الجزائر الخ..
وإزاحة هذه السيطرة لا يكون بفعل نضوج الطبقة الوسطى، فلا تظهر طبقة قادردة على وراثة النظام القديم بشكل حقيقي، بل بفعل تدخل خارجي كالعراق، أو بفعل أزمات مركبة كفلسطين، وهذا يؤدي إلى استعادة التكوينات العتيقة دورها فتحدث فوضى وحروب طائفية ومناطقية.
إن هذه الأزمات ستدوم طويلاً بل سوف تعرقل كذلك عمليات الحل الموضوعي لأنها تقود إلى العنف الذي يغدو هدراً للموراد.
وتعبير ( الفوضى الخلاقة) الذي يستخدمه الغرب في عملياته الجراحية للعالم الإسلامي، تعبر عن فقدان الحل الموضوعي، لأن الحل الموضوعي يتطلب عشرات السنين، فليس بالأوامر تنشأ المصانع والتجارة الحرة الخاصة، وليس بالأوامر يفك رجال الدول المتنفذون سيطرتهم على الأسواق والمداخيل، وليس بالأوامر تنشأ أفكار دينية متفتحة ديمقراطية توحد أي شعب..
ولهذا فإن كلمات مثل التقريب بين المذاهب والتسامح الديني والتخصيص ومراقبة المال العام وغيرها هي الشعارات العامة للدخول إلى فضاء التغيير ذاك..
من هنا يغدو نموذج الحلول الصغيرة المتراكمة والذي هو نموذج مصر، وليس نموذج الحل التفجيري كما هو العراق، أفضل للقوى السياسية في البلدان التي بعد لم يفجرها الصراع السياسي.
إن تراكمات الحلول وإجراء تغييرات صغيرة متراكمة وإدخال القوى الشعبية في عملية الحكم والمسئولية والإنتاج هو الطريق الذي ينبغي |أن تسلكه الدول والفئات الوسطى ذات الثروة.
فهذه الفئات لاتريد أن تصعد فئات ثرية جديدة وهي تقبض على السوق بوسائل سياسية متعاونة مع الأنظمة القديمة، وهي لا تطور قواها المنتجة الوطنية، مفككة السوق بأشكال شتى، وتعاضد أشكال المذهبية المحافظة وأقتصاديات السوق الاستهلاكية المدمرة للتراكم الرأسمالي الحقيقي.
لكن مهما جرى من تغيرات نظل على بوابة التحول الديمقراطي التاريخي، ولا نعرف كيف سيتم تجاوز صراع الدول المسيطرة والمعارضة الدينية، فهل سينبثق تكون جديد، وينصهر الفريقان في تكوين تحديثي ديمقراطي أم يواجهان الأمور نحو التفكيك الكامل للدول والمجتمعات؟
أم أن صناديق الاقتراع سوف تخفف من قبضة كلا الفريقين على الموارد والسلطات؟
معاني الديمقراطية في الشرق
تحتاج المجتمعاتُ الشرقيةُ إلى عشرات السنين للاقتراب من الحالة الديمقراطية، فباستثناء المجتمع الهندي والياباني فليس ثمة إمكانية حالياً لتشكيل ديمقراطيات في آسيا وأفريقيا. المجتمع الهندي مجتمع فريدٌ من نوعه، عرف تعايش الأديان والقوميات، فأضفى عليها حزبُ المؤتمر في صراعه مع الاستعمار البريطاني صفة قانونية عميقة. بينما المجتمع الياباني أعطتهُ العزلةُ والتحولاتُ الداخلية الصناعية إمكانيةَ الاقتراب من الديمقراطية فتشكلت فيه بصورة فاشية كما بدا ذلك في الحرب العالمية الثانية، حتى جاء الاحتلالُ الأمريكي فجعله في ظل الديمقراطية الغربية وبهيمنة الطبقة الرأسمالية فيها.
نحن نفهم الديمقراطية باعتبارها حالةً سياسيةً تعني سيطرة الطبقة الوسطى على السلطة، فهي كذلك دكتاتورية، لكنها دكتاتورية تقدمُ للطبقات الشعبية مستوى من الحريات أفضل من المجتمعات الاستبدادية، لكن ما عدا ذلك فممنوع، وهذا تعبير عن مستوى تطور.
وبطبيعة الحال تنشأ فتراتٌ استثنائيةٌ تغدو فيها الطبقاتُ متقاربةً حينما يسقطُ نظامٌ استبدادي قديم، أو يواجه المجتمع مستعمراً ما فتتوحدُ الجهود، فتنشأ حالةُ نهوضٍ اجتماعية كبيرة، لكن تكون مؤقتة بطبيعة البناء الاجتماعي البشري المحدود في ظلِ إنتاج راهن عاجز عن خلق مساواة حقيقية، وفي ظل تنامي مصلحة طبقة عليا دون بقية الطبقات.
إن الانفراجات الشرقية والتبدلات السياسية التحديثية ليست هي حتى بمستوى الديمقراطية الرأسمالية الغربية، فهي صراعاتٌ داخليةٌ بين قوى اجتماعية تقليدية لم تصل احداها لتكون قوة ديمقراطية، وكل مجتمع يحمل بصمته الخاصة في ذلك، فليس ثمة فورمة لوصف مثل هذه الصراعات المختلفة.
فهناك قوى تقليدية ربما تريد وراثة قوى تقليدية حاكمة سابقة، للحصول على بعض امتيازاتها الاقتصادية ومواقع نفوذها، ويبدو ذلك في نوعية الأحزاب المناطقية أو المذهبية عادةً التي تعبرُ عن الاختلاف مع النظام السابق، غير أنها لا تختلف معه في تشكيل جماعة جديدة تقبض على مفاتيح السلطة.
ولعل هذا القبض يتم في مناطق جغرافية مبعدة عن التأثير في السلطة السابقة، فتظهر بصفة حكم أقاليم أو جمهوريات أو قوميات كما حدث ذلك في سقوط النظام السوفيتي أو العراقي، لكنها تظل سلطات شمولية جديدة، اتاح لها التحول السياسي المغمور بعاطفية قومية أو دينية شديدة، أن تحصل على أصوات كبيرة للوصول للحكم.
بطبيعة الحال هناك لحظة تقدم حتى في هذا التحول، فالنظام الشديد المركزية لم يلتفت إلى مشكلات الأقاليم أو المناطق المحرومة، أو الأثنيات المغبونة، فتأتي الأنظمةُ الجديدةُ لتعدل مثل هذه السياسات إلى حين، وهذا يعتمد على مهارة القيادة السياسية، لكنها لا تستطيع أن تخلق ديمقراطية، فهي ترتب الأوضاع ترتيباً خاصاً لكي تسيطر وتبعد الآخرين، معتمدة على الحماس القومي أو الديني.
إن المستوى الغربي الرأسمالي الديمقراطي صعب على الدول الشرقية، فغالباً ما يكون (الديمقراطيون) الشرقيون اصحاب نفوذ كبير في الدولة، يريدون إعادة توزيع حصص الامتيازات الاقتصادية، في حين إن الديمقراطيين الغربيين يكونوا ممثلي طبقة رأسمالية غنية لا يحتاجون لأجهزة الدولة لكي يثروا من خلالها، بل إنهم جاءوا ليكرسوا حكم طبقتهم كلها وربما يقدمون انجازات للطبقات الشعبية في بعض جوانب الأجور والأسعار والخدمات، وتكريس حكم طبقتهم يعني وضع سياسات اقتصادية تتعلق بمستوى الضرائب أو بتحفيز التصدير، حسب وضع الطبقة الاقتصادي الصراعي، مع طبقات أخرى في بلدان منافسة، أو لتحفيز الطبقة المنتجة في بلادها أو دفعها لمزيد من العمل، وهذا البرنامج المؤقت قد ينجح وقد يفشل وقد يُكرس في انتخابات جديدة أو يُهزم، ليظهر برنامجٌ آخر أكثر مقاربة للوضع ولمصالح المجموعات السكانية الأوسع، وهذا ما يفسرُ التناوبَ المستمر بين أحزاب اليمين واليسار في الغرب.
لكن الجماعة التي تحكم في الشرق أو القوة السياسية التي تصل للسلطة في الدول الشرقية، لم تكرس نظاماً لحكم طبقة معينة من خلال الإرادة الحرة للسكان، وهذا ما يجعلها دائماً في تحالف مع العسكر، ومن هنا فليس ثمة ديمقراطية شرقية بل عمليات طبخ سياسية تقوم بها القوى المؤثرة على الساحة.
وللوصول إلى مستوى الغرب أو الاقتراب منه يلزم الكثير من الثقافة العلمية والسياسية مع وجود قطاع خاص قوي ووطني، فليست الديمقراطية الهندية بلا عوامل موضوعية، فبدون القطاع الخاص الصناعي والتجاري الكبير الذي تكون والمعتمد على قوى عمالية هائلة، لم يكن بالإمكان جعل التعددية الفسيفسائية السياسية لتدخل في منافسات ضارية من أجل الحكم.
ولهذا كل ما يُرجى في مثل هذه الأوضاع والحالات التخفيف من قبضات الدول والجماعات القومية والدينية وخلق قطاعات خاصة لا تعتمد على الأثراء الحكومي، ترافقها ثقافة تحررية ودينية مستنيرة، توجه الجمهور لانتخاب الأفضل فهماً للظرف السياسي والقادر على دعم مثل هذه التحولات باتجاه الديمقراطية.
إن تكريس مرحلة انتقال للديمقراطية هي مسألة أجيال ومعارك وتنوير وتثقيف هائل، لتفكيك سيطرة الدول عن المال العام، ومنع أية قوة أخرى من الانقضاض على هذا المال العام، فهي عملية صراع مع كل القوى الشمولية.
الديمقراطيةُ طريقٌ واحدٌ
مع غياب الطبقة الوسطى من مجتمعات عربية مثل العراق والبحرين وبعض أقطار الجزيرة العربية تصبح الديمقراطية صعبة أو غير ممكنة.
شكلت الطبقة الوسطى وجودها بصعوبة في بعض الدول العربية، وحتى الآن لم يُعرف حجمها وتكويناتها، أي مدى حجم الرأسمال الصناعي وبقية الرساميل التكوينية المحورية فيها، ومستوى مؤسساتها العلمية وقدرتها على فهم الإنتاج وتطويره، حتى الآن هي في بعض الدول العربية فئات مهمة تتقارب لتصعيد أو ربما لتقزيم الرأسمال الصناعي، وهذا يعود لمستوى وعي تنظيماتها السياسية، ومدى فهمها لتطور الإنتاج الصناعي- العلمي في إعادة تغيير البناء الاجتماعي الاقتصادي التقليدي بموصفات الحداثة.
تلك الدول خلقت تراكمات على مستويات عدة، في حين أن الدول في الجزيرة العربية بعيدة عن ذلك والأسباب كثيرة: تصحرٌ إجتماعي لقرون، ومدنٌ هامشية، وصناعات إستخراجية هي الأساس لم تقدر على تحويل معظم السكان لعمال ومنتجين وملاكاً، ودولٌ تمتلكُ أغلبَ الفوائض وتتصرفُ فيها بأشكال غير مدروسة إجتماعياً ومرّحلة غربياً.
إن الدولَ لا تستطيع أن تخلق وتؤسسَ ديمقراطية، بل تخلقُها الطبقةُ الوسطى الحرة، يخلقها رجالُ ونساءُ الأعمال وهم مؤسسو المصانع والشركات الذين يربحون من دخولِ مؤسساتهم، وبالتالي لا يخشون شيئاً سواءً كانوا داخل أو خارج الحكم.
يدخلون الحكمَ لتغيير أحوال طبقتهم وزيادة ثرائها مع خدمة بقية الطبقات وزيادة أجورها وتحسين أحوالها في عملية تطوير إنتاج ضرورية لكل المواطنين، ولكي يكسبوا أصواتهم لحكمٍ تال.
الشفافية والعقلانية والحداثة هي جزءٌ من تكوين طبقتهم، وتغيير أشكال الإنتاج القديمة هي من مهماتهم الاقتصادية الاجتماعية.
تساعدُهم وتصارعُهم الطبقاتُ العاملة حسب مسار إصلاحاتهم، وهذه القوى العاملة حتى حين تشاركُ في الحكم تدخلُ تعديلات وتطورات على النظام الرأسمالي من موقعِ مصالحِها ومن موقع تطوير البنية الاجتماعية ككل.
وبدون هذه السياقات يَصُعب الحديث عن الديمقراطية.
ونحن في الجزيرة العربية خاصة علينا أن نقدم العتبات الأولى لظهور هذه البنية الاجتماعية. نشكل فقط بذوراً ديمقراطية لنترك للأجيال القادمة زراعتها.
فلا بد أن تتخفف الدولُ من تشييدِ المصانع والمؤسسات الاقتصادية التي تُصمم بطرقٍ بيروقراطيةٍ دون أشكال ديمقراطية، ودون دراية بطبيعة النظام الاقتصادي وكيفية تطوره العقلاني وقدرته على خلق تطورات إقتصادية وجذب العمال العاطلين المواطنين والشرائح المهمشة وجعلهم أغلبية منتجة بدل إقتصاد هدر العمالة ورأس المال القائم.
ولا تحدث الديمقراطية إلا من تحرك الفئات الوسطى نحو الإنتاج والأسواق شبه المحتكرة الآن للدول، وبالتالي فإن الأجهزة الحكومية الراهنة وهي المهيمنة على الاقتصاد والحياة الاجتماعية لا تستطيع خلق ديمقراطية، يُفترض فيها وجود إقتصاديات حرة وتداول للسلطات.
ومن هنا فلا بد من أن تكون الملكيات الخاصة في الإنتاج خاصة هي الأساس الاقتصادي.
الديمقراطية تخلق في قرون، ولكن هذا لا يعني عدم خلق البذور الراهنة والمقدمات الاقتصادية والسياسية والفكرية.
الهيئات الحكومية والجماعات السياسية الأهلية شمولية، تعيشُ في عالم الحرب الباردة وآثارها، وفي الرأسماليات الحكومية الشرقية وأفكارها، وهي بعد لم تقتنع في أعماقها السياسية، وفي هياكل عظامها بالديمقراطية.
أهم سمتان الديمقراطية هما العلمانية وتبادل الحكم، وهما سمتان يصعب القيام بهما في المنطقة. لكن هل نقف دون أن نتقدم نحوهما؟
تطبيق العلمانية يعني عدم إستعمال الدول والمنظمات السياسية للدين ومنتجاته في الحكم والعمل السياسي، ودون ذلك لا تتحقق الديمقراطية.
محاولات القفز والمناورات والإختراقات على ذلك بدون فائدة، لكن هذه لا تستطيع أن تفعلها الدول والجماعات الأهلية السياسية، ولا توجد فئات وسطى قوية تؤسس للأسباب الموضوعية السابقة الذكر.
الدول والجماعات الدينية إستخدامها للدين سياسياً يعبرُ عن شمولياتها، فلا بد للتقدم لأولِ خطوة نحو بذرة الديمقراطية من وقف ذلك.
الجماعات البرجوازية الصغيرة وتنظيماتها لا بد أن تدركَ أهميةَ الدخول في طريق الديمقراطية، وتنقدَ تاريخَها وشموليتها، وتمشي في طريق الحداثة والعلمانية والرأسمالية الحديثة، ولا أن تحولَ أفكارَها لرأسِ مالٍ تأخذهُ من الدولِ كإنتهازيةٍ مدفوعة الأجر، أو من إستغلالِ العامةِ من خلال المزايدة والمغامرة، مدفوعة الخسارة من مال الناس.
لا بد إذا أرادت أن تصيرَ رأسماليات أن تتوجه لبناء الأعمال الخاصة والمؤسسات التجارية والصناعية، بدلاً من تحويل السياسة لرأسِ مالٍ، فلا تشارك في سد مجرى تغيير العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بمنع التوجه نحو الرأسمالية الحرة.
في السياسة والوعي تؤيد تراكم المال وقوى العمل من أجل الخروج من الدول التقليدية، ومن أجل أن يغدو الهدفُ المحوري للمجتمع وهو تبادل السلطة ممكناً، عبر زوال التتنظيمات الشمولية غير القادرة على أن تكون ديمقراطية أساساً.
لا ديمقراطية من دون علمانية
تأخر المسلمون في الدخول إلى الحداثة والديمقراطية خلال القرون الأخيرة بشكل مأساوي، وحين يدخلون الآن بصعوبات جمة وبثورات مضحية عظيمة يقودها الشباب الديمقراطي العلماني يواصل المحافظون السياسيون والدينيون التشبث بسلطاتِهم شبه المطلقة.
تنافس مجرد عند صناديق الاقتراع حيث تبدو الديمقراطية العربية زاهية الألوان، في حين أن الشموليات الدينية خاصة تجرها من مسامها وخلاياها إلى الماضي والاستبداد.
المؤسسات الدينية الجماهيرية مجيرة لأسماء، والجمهور البسيط يُساق عبر الشبكات الاجتماعية المذهبية التي كونت خلال زمنية عهود الاستبداد الماضية، من أجل أن يصوت لقوى تقليدية جديدة، فبعد أن عانى الاقطاع السياسي عليه أن يعاني الاقطاع الديني وقد تحول إلى اقطاع حاكم ولكن إلى متى؟
لن تكون الديمقراطية سوى هيمنة معينة، فليس ثمة حرية مطلقة ولا ديمقراطية مطلقة، ولكن هذه الهيمنة الجديدة ما هي مقاربتها للحريات العامة وتطوير حياة الجمهور المعيشية؟ وهل هي تمثل نقلة باتجاه تطور هذا الجمهور السياسي بحيث يغدو قادراً على الاستقلال من شبكات الماضي القروسطية التي هيمنت عليه خلال العقود الأخيرة خاصة؟
حركت الحياة السياسية خلال العقود الأخيرة الجماهير العربية باتجاه التطور الاقتصادي الحديث نسبيا، وأنشأت أجهزة حديثة ومشروعات عامة وطورت الحياة الاقتصادية الخاصة، لكن هيمنة الدول التي قامت على هياكل تقليدية، خاصة هيمنة العائلات والقبائل حسب مناطق معينة أغلبها بدوية وريفية وحضرية جزئية، فشكلت اقطاعات سياسية في الدول العربية لهذه العائلات والقبائل والجماعات العسكرية والسياسية المتقاربة التي استغلت الملكيات العامة بجزء كبير لها.
ولم يكن بإمكان أحد منظم سياسيا أن يعارض أو يقاوم هذه السيطرات التي كانت تفتتُ قدراته، وتجهض تنظيماته، بدواع متعددة، ولكنها لم تقدر على التنظيمات الدينية التي لجأت إلى الاحتماء بالموروث، وشبكاته الاجتماعية الممتدة في الأشكال التعاونية والخيرية الزائفة شكلاً والمبطنة بسيطرات عائلية وقرابية وسياسية مذهبية ودينية.
يجب الفصل هنا بين شكل السيطرة ومضمونها، فالوزارات الحكومية والمصانع والبنوك التي غدت أجزاء اقتصادية من الدول ذات القطاعات العامة بشكل كبير، والتي تجرى فيها الأشكال الحديثة المستوردة، تقوم بخدمة قوى تقليدية، فتتوجه الفوائض لبناء قصور أو دعم مشروعات ثقافية تقليدية، فرأينا تنامي الشعر التقليدي والأشكال العامية المتخلفة من الأدب، وإعادة الاعتبار لأشكال موروثة من العادات وجرى التعصب لها، فقام رأس المال بدعم الاقطاع الماضوي في الحكم وفي الحياة عامة.
من هنا رفضت القوى المعارضة ذات الجمهور العامي بشكلٍ خاص أي تلويح بالديمقراطية العلمانية الفاصلة لاستخدام المذاهب والأديان في الحراك السياسي، وهو الأمر الذي لم يعارضه بعض الدول ولا أغلبية الأحزاب الحديثة، لأن ليس لها منفعة في هذه الأساليب السياسية المندمجة في السيطرات الدينية.
وهكذا فإن الشكلين من الاقطاع السياسي الحاكم والديني المعارض، أججا أساليب عتيقة في الحياة العربية وصعدا الموروث المحافظ بأشكال سلبية.
وهذا يمكن أن نلاحظه في العودة للقبائل والمناطقية وتضخم الأرياف في مواجهة المدن، وتفكك الدول فدولة عريقة كالعراق تتحطم في بنائها السياسي الوطني، وكذا السودان وسوريا وغداً غيرها من كل الدول العربية، وهنا تقوم الديمقراطيات الطائفية بهدم ما تبقى من الدول العربية ككيانات مؤسساتية، وهذا لا يتعارض مع الثورات العربية التي قادها الشباب الديمقراطي العلماني غير المنظم الذي سُرقت ثوراته منه.
لقد حدث ترد كبير في عقليات الجماهير العربية من الأجيال السابقة خاصة، التي سُحبتْ من الثقافات التحديثية الديمقراطية والتقدمية، وحُبستْ في الأشكال الإحيائية المحافظة الزائفة الانتماء إلى الإسلام بغيرِ ما تقول، فهي تمثل الثورة المضادة للإسلام التوحيدي، هي مذهبياتُ التفكك والتخلف واللاعقلانية.
وبهذا فمع عجز الاقطاع السياسي الحاكم عن تحويل الاقتصاد والثقافة للديمقراطية تحدث أزمة بنيوية، لأن الإقطاع لم يغد برجوازية حرة، فتحل الآن أزمة جديدة أكثر تعقيدا وتحللا لأبنية الاستقلال السياسية العربية، وتبدو «بشائرها» بعمليات التفكك الواسعة في كيان الدول، وأن تغدو الدول لا دول، بل كياناتٍ منفصلة وأقاليم وصراع مدنٍ وقرى، وهويات اثنية وطائفية وقومية.
وإذا كانت الدول قد رفضت العلمانيةَ جزئيا والديمقراطية كليا، فإن الدويلات الجديدة وطلائعها الطائفية ترفض العلمانية كلياً وتقبل الديمقراطية جزئيا، فتحدث النتائج نفسها، لأن الديمقراطية تغدو أداة السيطرة الاستبدادية المموهة فيما العلمانية تمثل نقضها وإزالتها.
فهي ذاتها حولت المذاهب والأديان إلى أشكال خالية من مضامينها الديمقراطية الإنسانية وصيرتها أدوات لاستغلال الفقراء وإبعادهم عن الحداثة والاستنارة، فلا قدرة لأشكال محافظة على تنمية حرية وتقدم وديمقراطية، وهذه كلها بسبب الوعي المتخلف للجماهير العربية وحبسها الطويل في ظلامية الأمية والجهل عقودا.
ديمقراطية غير علمانية، أهي ممنكة؟
حسمت جماهيرُ الأقطارِ العربية في مصر وتونس التوجهات الاجتماعية بالاندفاع نحو ديمقراطية علمانية بدت شفافة وغير مؤدلجة ومتسامحة دينياً ووطنية متجاوزة للتفرقة الدينية والمذهبية، وذلك لكون البلدين لهما تاريخ ثقافي تحديثي طويل، ولو أن الأخوان المسلمين قادوا الثورتين لبارتا وتمزق البلدان.
جنوحُ الجماهير تقودها الأجيالُ الجديدةُ المتعلمة الحديثة للبلد الذي لا تستغله طائفةٌ ولا يعيش تحت هيمنة ديانة واحدة، ويغدو بلداً متسامحاً، ديمقراطياً يركز على التغيير المعيشي، وهذا هو سبب الانتصار.
لكن الجماعات الدينية المغلقة لن تدعَ الناسَ تمضي للديمقراطية الحداثية، فحين يحدث ذلك ماذا ستفعل وأين تولي وكيف تحمي إستغلالها للجمهور؟ فلا بد أن تقاوم إنهيار سلطتها بقوة، كما عملَ الحزبُ اللاوطني اللاديمقراطي وصمد من أجل بقاء إستغلاله للجمهور زمناً طويلاً أستغل كافة الأدوات ليواصل عصر شرايين الشعب في خزائنه.
وما أسهل للدينيين المغلقين إثارة العواطف تجاه المسكرات وعورة المرأة والفنون وإثارة الشعب نحو قضايا جانبية قبل أن تجفَ دماءُ الضحايا من على الأرصفة وبلاط الشوارع.
رجلُ السلطة ورجلُ الدين في الشرق وجهان لعملةِ إستغلال الشعب، الأولُ يركزُ على قداسةِ العلم الوطني وخريطة البلد وقوانينه وأرضه التي تُفدى وتُحمى بالأفئدة، والحدود والرموز المقدسة، وكل هذا الكلام لكن المقدس لديه فعلاً هو الخزائن وكيفية تكديس الأموال وتجميع الثروات، وها هو كل هارب كبير تُوضع ثروته على شاشة الفضاء العالمي مُقاسة بالمليارات المكشوفة الواضحة، فأين ذهبت قداسة الوطن؟
ورجل الدين لا يختلف عنه، يحولُ رموزَ الدين المقدسة لدى المؤمنين من صلوات وكتاب ومناسبات إلى سيطرة على الناس وإستغلال موارد عيشهم وهيمنة على أرواحهم حتى لا تطير نحو العقلانية والحرية.
ألا ترى كيف يستميتون لملءِ بيوتهم بالأشياء الثمينة والأموال والأغذية؟ ألا ترى كيف يخافون أن يتحرر الناس ويغدون حداثيين يعبدون اللهَ دون وسائط ماكرة؟ ويمارسون شعائرَهم الدينية دون وكالاتٍ تجارية وسمسرة إجتماعية؟
فهل يمضي عربُ الحرية السياسية نحو سجون جديدة؟ ويستبدلون النار بالصحراء الضارية؟
لا أظن ذلك، ومهما فعلَ المجلسُ العسكري لكي يعيدَ ذات الطبقة القديمة بوجوه جديدة، وأن يواصل الإقطاعان السياسي والديني هيمنتهما على الشعب بأشكال رقيقة في البدء، فإن الشعوبَ العربية وخاصة الشعب المصري، قد أكتوى بالاثنين، ويريد بلداً حراً على الطراز الأوربي الديمقراطي الحديث، ولا يريد مواصلة العيش في زنزانات الأنظمة الدينية السياسية، يريدُ حكومةً تركزُ على تطوير عيشه ولا تفجر الخلافات بين المذاهب الإسلامية والأديان السماوية، فقد شبعتْ الشعوبُ من هذه الكوارث ومن الإدعاءات الأخلاقية المثالية، وأصحابها أكثر الناقعين في عسل المادة، وصانعي عالم الجواري، والبؤس الأخلاقي.
وها هو العراق بعد أن رسّخ سلطات الجماعات الطائفية الاستغلالية يثور مطالباً بخبزه الضائع، وأمواله الهاربة من يديه التي تتجاوز أسلاك الحدود وهي تحملُ الملايين، وينعى أعماله المتوقفة وحضارته التي هدمها السياسيون الشموليون والدينيون الطائفيون.
الديمقراطيةُ الحقيقية هي أن لا يكون حزباً واحداً مهيمناً فيها، يعيشُ أبديةَ الكراسي والخزائن، ولا أن يقبض الحزب الديني على عنقه ويمنعه من الطيران في عالم الحرية والاختيارات الأخلاقية والعقلانية.
إذا كان الحزبُ السياسي يمكن أن يتغير فإن الحزب الديني يربط نفسه إدعاءً بالذات الإلهية والسماء والمقدسات كلها، فكيف سيتبدل ويسمح لآخرين بنقده وكشف أمواله وإستغلاله؟
لقد جرب العربُ الأحزابَ السياسية الشمولية الدينية فهل يستمرون في التجريب الخائب؟
هل يعرضون بلادنهم للحرائق والخرائب في كل مكان؟
هل ينخدعون بالكلمات عن الطائفة المقدسة والحزب المقدس والجماعة التي لا يأتيها الباطل؟
(الدينُ لله والوطن للجميع)، قالها المصريون سابقاً، ولا بد أن يستعيدوها بشكل أكثر حداثةً وديمقراطية، وأن لا يجربوا الأنظمة الدينية الشمولية ومرارات الأحزاب الدينية بعد أن عانوا طويلاً من الأحزاب السياسية العسكرية.
الإسلام دين الديمقراطية والعلمانية
حين حدث الانقلاب على الأسس الاجتماعية للحكم في (الفتنة الكبرى) وما بعدها من نتائج استمرت ليومنا هذا، انقلبت تلك الأسسُ رأساً على عقب.
لم يكن ثمة ضرورة لأحزاب تقوم على أساس ديني، لأن الحكم هو للأغلبية الشعبية، وكان كبار الأغنياء قد أُبعدوا عن السيطرة على السلطة، ولهذا لم يخطرْ في بال عامة المسلمين أن تظهرَ أحزابٌ سياسية دينية، لأن الإسلام هو صوتُ الأغلبية العاملة.
وفي بداياتِ الانشقاق اعتبرتْ الأحزابُ السياسية المتوارية تحت لافتاتٍ دينية، إنها مع ذلك الميراث الرافض للأحزاب السياسية الدينية التي تمثل خروجاً عن دربِ السلف!
أخذت فئاتُ كبار الأغنياء التي وصلت للسيادة السياسية في صفوفِ مختلفِ الفرقاءِ المتصارعين على الحكم والثروة، وراحت تصورُ نفسَها أنها الوريث لما قامتْ بتحطيمهِ وإلغائهِ من التاريخ لجماعة المسلمين!
وحين جاءَ أي حكم مذهبي سياسي في هذه الطائفة أو تلك قام على نفس أساس الهيمنة الطبقية، فيصور نفسه بأنه الممثل للدين الحقيقي، وفي ذات الوقت له خزائنها المليئة بالمال والسندات والأراضي، وحين تقول فئة أنها ممثلة الإسلام تقوم باحتكار الثروة العامة وتحويل حزبها العسكري السياسي إلى القوة المهيمنة على العاملين. كان تاريخ الأغنياء الحاكمين المحدودي العدد بين أغلبية الفلاحين والبدو والفقراء.
وفي ذلك التاريخ تكونت جذور الجماعات الطائفية السياسية المعاصرة، فكانت الجماعاتُ السابقة تقتطعُ خيوطاً صغيرة من النصوص وتركبها على مصالح جماعة حاكمة في مختلف تضاريس العالم الإسلامي، وتحيل نفسها إلى حارسة للمذهب، وبالأحرى إلى معتقلة لتطور المذهب وتعبيره عن الناس.
فكان الحكام المستبدون يرون مدى شعبية هذا المذهب أو ذلك، ومدى قدرته على تكريسه لسطوتهم، ويكونون على أتم الاستعداد لتغيير المذهب وجعله سائداً في البلد الذي يحكمونه متى ما كان مفيداً لتكل المصلحة
غدا مثل هذا التسييس ميراثاً عميقاً متجذراً، توظفه الجماعاتُ السائدة لانفصال دولة عن أمبراطورية، أو في هدم أمبراطورية، ويوظفه المغامرون السياسيون إذا ما ركبوا على أجساد القبائل المطايا للوصول للكراسي.
والدائرة تدور والطاحونة تفرمُ عظامَ الناس، والقصور تمتلئ ثم تتحول لخرائب، وتتجدد ثانية بالمتع والعطايا والكنوز ثم تـُهدم وهكذا دواليك، وإستغلال الإسلام يقوم به أي لص أو مغامر أو ثائر كذلك، لكنه يتحول مثلهما، فلا عقول تتسع ولا معرفة عميقة تتراكم، ولا حضارة تبقى.
كان هاجس الوحدة قوياً في الإرث الأول، لأن الأرثَ وحدَّ مصالح الأغلبية، رفض صعود الطبقية العليا، الفرعونية، والملأ المالي، وجماعات الربا الفاحش، وأبناء الأكرمين، فاستخدم الملأ البنكي والسلطوي والجمهوري والملكي ورقة التوت الرقيقة؛ الصدقات، والتظاهر بالتقوى، والشكليات الديكورية الخارجية، ليتظاهروا بوحدة موهومة غير حقيقية للمسلمين، تفرقها كل يوم الضرائبُ على كواهل الناس، وتراكمات الثروة هنا وتراكمات الحرمان هناك، السجون المفتوحة هنا والسفرات والصناديق المُهّاجرة هناك.
صارتْ الأقفاصُ المذهبية السياسية ضرورية، للحفاظ على هذه الهيمنات، رغم أنه حتى الهيمنات الطبقية الحداثية تصاعدتْ في أغلبية الدول الأخرى دون الحاجة لمثل ورقة التوت تلك، والحالُ اليائسُ يقول أسرقونا لكن دعوا عنكم التلاعب بالدين!
لكن الوحدة الدينية المأزومة الموهومة هذه تزيد الانشقاقات والحروب والمعسكرات، لأن مئات الملايين تؤمنُ بها، ويظهر مغامرون من كلِ حدبٍ وصوب، يتنطعون لمثل هذه المهمة الجليلة المستحيلة الآن، فيركبون الطائرات للمغامرات ويتمردون بالجيوش ويقتطعون أجزاء من الدول لإقامة دول قطع اليد، والديكورات سهلة، والأكسسورات برخص التراب، ويقدم متعلمون جبالاً من الكتب للحفاظ على التفاسير العتيقة والتعصب الديني والتعصب القومي.
ويزداد حرج بعض رجال الدين العقلانيين من هذه التجارة بالمقدسات، لكن الأغلبية ماضية في المزاد الرهيب، فيتوارى هذا البعضُ ويقدمُ السياسيين دون أن تحدثَ عملية فصلٍ عميقةٍ بين المقدسِ والسياسي، بما كان أساساً للتوحيد، وما هو صار أساساً للصراعات على أموال الدنيا، بما كان تراثاً عزيزاً سامياً توحيدياً، وما هو عراكٌ على الإبل والنقود ونهب الأراضي!
وقد وصلتْ العملياتُ الصراعية إلى ما هدَّم دولاً (إسلامية) ،(بل قلْ تاجرت بالإسلام)، ونرى أمامنا جحافل المسلمين المساكين وهم يحملون عفشهم البائس مثلهم ويرفعون أطفالهم على أكتافهم، ليفروا من الصواريخ والقنابل، والطائرات (الإسلامية) تضربُ منازلـَهم وقراهم ومزارعهم، والجماعات الرافضة (الإسلامية) تطلقُ عليهم قذائفـَها وتحرقُ مزارعَهم وعالمهم الهادئ الساكن!
وتجمع الدولة (الإسلامية) الأموالَ وعَرق الملايين في مخازنها للجماعات المقربة، والإقاليمُ النائية (الإسلامية والمسيحية وغيرها من الملل) محرومة، عطشة للماء، ويقول رئيسهم (الإسلامي) للجمهور (سنعطيكم الماء!)، ويصيرُ ابناؤهم الضباط حكامَ البنوك والشركات الدنيوية و(الإسلامية)، ليواصلوا ثقافة الفتنة الكبرى، أي ليضعوا مخططات تدهور الدول الإسلامية وتمزقها، وبدلاً من الأفراس ورباط الخيل يُعدون به عدة لضرب المسلمين، يستخدمون قذائف الهاون ومدفعية الدبابات سلاحاً يرهبون به المطالبين عن أخذ أنصبتهم المتواضعة في الميزانيات والأموال التي انتجوها.
انظرْ إلى خرائط الرعب في إفغانستان وباكستان والسودان والجزائر، سيول من الحروب وضحاياها الفقراء، ولا جماعة طائفية قامتْ بالتبدل والتوبة من هذا الميراث الدامي.
ليس ثمة أكثر أسى من رؤية ما يجري في باكستان الآن مئات الآلوف من البشر يتشردون في لحظة، هنا يفقدُ الناسُ بيوتـَهم الرثة، وهناك في أمريكا يفقد الأغنياءُ فللهم الفارهة من الفساد المالي والبذخ، صورتان تمثلان وجهين لعملة دولارية واحدة، فبؤسُ باكستان تغذى من دكتاتوريات عسكرية استخدمتْ الدين مطية، ونهبتْ خيراتِ البلد ورحلـّتها للغرب، وتلاعبت بهذه الثروة قوى مالية غربية كبرى إلى درجة الجنون بذخاً وعسكرة. ولكن هؤلاء الفقراء الباكستانيون يتعرضون للموت في كل دقيقة، وأولئك الأغنياء يُعرض عليهم التعويض!
September 13, 2024
You Tube
September 5, 2024
المكوناتُ الديمقراطيةُ في التراث
كتب : عبـــــــدالله خلـــــــيفة
المطلقُ والنسبي، الإلهي والبشري، الباقي عبرَ العصور كأساسٍ نضالي لجماعاتِ المسلمين، والمتحول التشريعي الجزئي، يتجسدان إجتماعياً بتحالفِ التجار الأحرار مع العاملين الفقراء والعبيد وقتذاك.
القرآنُ كتابٌ نضالي مطلق، وكتابُ تشريعاتٍ نسبية متغيرة، يعبرُ في زمنِ عدمِ وجودِ المصنع كأساسٍ إقتصادي للمجتمعات وقتذاك، ومع ذلك يطرحُ التحالفَ الاجتماعي السابق الذكر، كجنين للبشرية الديمقراطية الذي حصلَ على وجوده الاقتصادي الواسع فيما بعد بأوربا الحديثة.
تشكل التحالفُ الديمقراطي عبرَ سورٍ محددةٍ كسورةِ الحشر، وأُعتبر ذلك أساساً للبناء السياسي للأمم الإسلامية، وغلبَ عنصرُ سيادة المُلكية العامة الخادمة للسكان على المُلكية الخاصة في الخلافة الراشدة، بما يعبرُ عنه في عصرنا بهيمنةِ الاشتراكية الديمقراطية السياسية على الليبرالية بشكلٍ جنيني رغم التحالف بينهما.
كان هناك نقص في الديمقراطية الاجتماعية وهو أمر ركزت عليه القراءات السطحية وأعتبرته دائماً.
غيابُ المصنع وسيادة الرعي والزراعة والحرف وسيادة البدو الأحرار والمدن التجارية القيادية، جعلت من المسلمين المشكلين الأساسيين للتحضرِ الديمقراطي النهضوي الجنيني وقتذاك في العصر الوسيط للبشرية.
الحضارة الأغريقية والحضارة الرومانية قامتا بدايةً على التجار الأحرار لكنهما وسعتا الحضورَ الهائل للعبيد فتدمر البناءُ الحضاري الديمقراطي فيهما، ولعبت الحروبُ والفتوح دوراً في الاسترخاء الاقتصادي والغيبوبة الاجتماعية والتناقضات الحادة بين الأمم والشعوب.
التحالف بين التجار الأحرار والعاملين أتخذ له مظاهر مختلفة في الحضارة الإسلامية عبر الفرق كالمعتزلة والسنة والشيعة وغيرها، لكنه إنتكسَ بهيمنةِ الارستقراطيات الحكومية وبتوسعِ جلب العبيد والجواري، مما أدى إلى تدهور المدن وإنهيار عالم المنتجين، بحيث تكلست قوى النقد والحرية والنضال الديمقراطي العقلاني في العواصم وأنعكس ذلك في سيطرةِ المحافظة على المذاهب والخرافةِ على الرؤى الفلسفية.
مع غيابِ التجار الأحرار والعاملين الأحرار أزدهر التفسيرُ الشكلي للقرآن، والتركيز على الظاهر، وجوهرة الإسلام في العبادات، بينما حاولت الفرقُ النضاليةُ والصوفيةُ البحث عن (الجوهر) في المطلق والغيب وليس في التحالف النضالي الحقيقي المفقود.
حين إستعادَ المسلمون وجودَهم الحديث وجدوا أنفسَهم تابعين لحضارةٍ جعلتْ من المصنعِ أساساً لوجودها وسيطرتها وتوسعها، وخصصتهم في المزرعةِ والسوق. وحين أسسَّ المسلمون مصانعَهم كانت كذلك منتجةً لموادٍ خام للمصنع الغربي المسيطر، وقدموا المواد الخام لها بأقل الأسعار. وهو أمر أدى إلى تناقض العالم العربي بين نمط يسترخي في ظل أسعار نفط وثروة بلا قوى منتجة عربية متطورة وأشكال من العمالة المجلوبة التي لا تعمق الإنتاج، وبين فقرٍ عربي يفتقد للثروة ويعيش العمالة في حدود الكفاف.
الليبرالية الأولى التي ظهرت في العالم العربي كانت إستيراداً فيما العاملون يعيشون في أوضاع عبودية، فهي لم تمد يدها بقوة وعمق لتغيير أوضاعهم، ولكي يكونوا شركاء لها في الوطن والسياسة والحرية، فجاءتْ الشمولياتُ العسكريةُ لتلغي الليبرالية والديمقراطية ولكنها حولت العاملين إلى ما يشبه العبيد في المصانع، فلم تصنع لا ديمقراطية ولا إشتراكية.
ركز المتابعون للتراث والحافرون من خلاله لرؤى سياسية على إستعادةِ الشكلاني والجزئي، وعدم قراءة الجوهري، والتركيز على السطحي يقود لاستعادة الملابس والأشياء الخارجية والجمل المحفوظة وليس قراءة التحالفات الاجتماعية الأساسية وتكويناتها الفكرية الثقافية وإستعادة حضورها بأشكال أكثر تطوراً وعصرية.
ظهر المصنعُ الآن بشكل واسع ولكنه في وضع مضطرب، لم يتحول إلى مهيمن على البُنى الحرفية والزراعية، أو لا يزال تابعاً للغرب يقدمُ مواداً خاماً، أو يجلب عمالةً غير عربية وغير مغيرة وغير متجذرة في نمط الانتاج، ولهذا فإن التحالف الاجتماعي الجوهري مختلٌ عبر عدم قدرة الفئات الوسطى لتوسيع التصنيع وإعادة تشكيل المجتمعات، وتوجهها للأرباح السريعة ومنافعها المباشرة، وتحويل العاملين لأجراء متخلفين، كذلك يظهر لنا المشهدُ العامُ الاختلالات في العمالة العربية بين عطالة في بلدان وجلب عمالة أجنبية في بلدان أخرى، أو تضخم العمالة الإدارية.
كذلك يظهر الصدام بين الرأسماليات الشمولية العسكرية الحادة والرأسماليات الليبرالية الضعيفة المتخلفة، فيحتاج العرب والمسلمون لتجاوز ذلك عبر أشكال متقاربة من التطور، وخاصة في الأنظمة الجديدة الحائرة بين أشكال التطور السياسية الاجتماعية، والتي يركز بعض منظريها ومثقفيها السياسيين على الجزئيات والسطوح وعلى القراءات غير الاجتماعية.
في حين تحتاج هذه التطورات لدراسات لكيفية تطور الثورة الصناعية الديمقراطية، وإعادة تشكيل رأس المال وقوى العمل، لهدف تلك الثورة ومقاربتها في ظروف كل بلد، لكن هذا لا يتم بدون التحالف الاجتماعي وظهوره بأشكال سياسية وتعاونية مختلفة.
August 28, 2024
الأعمال الصحفية الكاملة. أفـــــق، 2024
الأعمال الصحفية الكاملة. أفـــــق، 2024
July 30, 2024
مراجعةٌ للعنفِ الديني
تتشكلُ الدياناتُ القديمةِ على أساسِ القبلية ونموها، التي تبعد عنا الآلاف من السنين، ولكن لا تزالُ مستمرةً فينا، ولهذا فإن صورَ هذه الألوهياتِ المؤَّسسةِ للدياناتِ تتبدلُ بين لحظاتٍ مجردةٍ إلى لحظاتٍ ملموسة تندمجُ في التواريخ وتضاريس البلدان والشعوب.
(أنا يهوه. تراءيتُ لإبراهيمَ وإسحاقَ ويعقوبَ إلهاً قديراً. وأما اسمي يهوه فما أعلمتهم به. وعاهدتهم على أن أعطيهم أرضَ كنعان، التي تغربوا فيها)، (الخروج 6:6-4).
إن تبدلَ الأسماء هو جزءٌ من تطورِ القبيلة، هو إنعكاسٌ لأطوار الترحل والبحث في زمن ما قبل الحضارة، ثم يأتي دخولها في الحضارة، وتأثرها ببعضِ مرتكزاتها، فتتوجه القبيلةُ للسياسةِ، وتصبحُ القبيلةَ – الدولةَ، وهي إذ تمارسُ ضَبطاً على شعبها الداخلي، ولا نعرفُ حتى الآن أشكاله، تواجهُ عنفاً خارجياً من قبل الدولةِ المصرية، التي تتوجسُ من كثافةِ تجمعِ هذه القبائلِ اليهودية العاملة في أرضِها التي بلغت أكثر من نصفِ مليون إنسان.
الرسالةُ الدينيةُ وصورُ الإلهِ المُنتَّجةِ والقيادة الدينية في هذا الظرف الصراعي، كلها تعبيرٌ عن نموِّ القبائل اليهوديةِ وتضخم السلطة فيها، أي إن الانقسام والصراع والانشقاق مراحل لذلك التطور السياسي الكامن، ولهذا فإن الصورَ الألوهيةَ تعبيرٌ عن هذا التبلور للسلطةِ السياسية المتصاعدة.
إن مرحلةَ الخروجِ تُظهرُ تجريبيةً قبلية دينية سياسية لم تتبلور طويلاً في أسس الحضارة ولا في نص، ولا في عقلية متبلورة بل تعيشُ ترحالية مضنية، ولكن الهدف السياسي موجود وساخن:
(فاعمل بما أنا آمركَ بهِ اليوم. ها أنا أطردُ من أمامكم الأموريين والكنعانيين والحثيين والفرزيين والحِويين واليبوسيين. لا تعاهدوا سكانَ الأرضِ التي أنتم سائرون إليها، لئلا يكون ذلك شركاً لكم، بل اهدموا مذابحَهم وحطموا أصنامَهم، واقطعوا غاباتهم المقدسة لآلهتهم. لا تسجدوا لإلهٍ آخر لأني أنا يهوه إلهٌ غيور. لا تعاهدوا سكانَ تلك الأرض لئلا يدعوكم حين يعبدون آلهتهم ويذبحون لهم فتأكلون من ذبائحهم.(الخروج 34: 11 – 15).
تقومُ أولوياتُ سلطةِ القبيلةِ – الدولةِ على العنف، عبر إزاحة الأقوام الأخرى، وعدم الذوبان في تقاليدِها الدينية والاجتماعية، وعبر هدم مؤسساتها، أي بكلمةٍ واحدة سحق الآخر المختلف، وإذا بقي حياً حراً فيجب من وجهة نظر هذه السلطة عدم التعايش معه.
هناك مسافة كبرى بين القبيلةِ المنتجةِ للعنفِ والزاحفة نحو إقامةِ سلطة على أرض وبين تحققها، فلاب د من فترة قبل السلطة وتتكرسُ فيها نظرتها، وهي رؤيةٌ عامةٌ للشعوب القبلية والأمم، ومن ها فصورُ الإلهِ سوف تصاب بالتعديلات المستمرة لكي تلائم نمو مضامينها الاجتماعية من جهة، وإختلافها عن الشعوب الأخرى من جهة ثانية.
فعلى حسب تقاليد القبائل اليهودية الوثنية، والتي لم تستطعْ العيش الحضاري في مصر لأسبابِ تخلفِ هذه القبائل، فإنها تواصل عبادة أربابها الوثنية القديمة، لكن المرويات اليهوديةَ الرسمية لا تخبرنُا بحالةِ هذه القبائل العبادية الحقيقية، إنها تقدمُ لنا هذه القبائلَ بصورةٍ تجريديةٍ مقدسة، نورانية، رغم بعض الاعترافات الوامضة، التي هي أشبه بفلتاتِ اللسان لكن المعبرة عما هو متوارٍ حقيقي في تاريخها السابق.
إن المرويات القصصية الشعرية اليهودية تقدمُ لنا البطلَ الرمزي هذا، والسماءُ تشاركهُ في صنعِ التاريخ، وتآزرهُ ضد أعدائه، مثل أي بطلٍ محظوظ ديني أو أسطوري، لكن هذه المؤازرة تتم بأدواتِ الوعي السحرية، ومستويات تطوره في النقل وكسب الغذاء والسلاح ورعي الحيوان.
ولكن الواقعَ الموضوعيَّ يختلفُ عن ما يصورهُ البطلُ عن نفسه، أو ما كتبهُ آخرون بعد أزمنةٍ بعيدة، وهم يكيفون تلك التواريخَ لزمنِهم، وينزعون منها أشياءَ كثيرةً هي خارج سياق التوحيد الديني الذي صاغوهُ تَميزاً سياسياً عن غيرهم، لتظلَّ السلطةُ فيهم، ولكي لا يذوبون في الشعوبِ الأخرى، فتذوبُ دولتُهم القبليةُ التي أسسوها، وهو ما ستفعلهُ الشعوبُ الأخرى كذلك وهي تتأثرُ بهِم وتصارعهم، وتطورُ تجربتَها السياسيةَ الخاصة وتشكل دولها.
من هنا شكلت القبائل اليهودية رمزية مقدسة نقية لتاريخها السابق، حيث الآباء يصارعون الحياة الوثنية ويختارون طريقاً آخر، ومن هنا يتم تصويرهم بشكل فردي رومانسي في تلك البيئة الصحراوية القبلية المتخلفة.
وهو أمرٌ مستحيل ومن هنا فلا يمكن أن تكون القبائل اليهودية في مصر غير وثنية، خاصة إن البيئة نفسها تعتمد على تعدد الآلهة وصورها وكثرة المعبودات.
ومن هنا فإن الأسماء المقدسة السابقة تلك تعبير عن هذا التاريخ المتواري، وعن القبائل والجماعات المترحلة والتي لم تكتسبْ تاريخَ عنف سياسي كبير مدون خاصةً، وحين ظهرتْ الكلمةُ المؤسسةُ:(إسرائيل) ظهر مصطلح الصراع العنفي هذا، فالإسم هنا هو عن الإله والإنسان في حالة الصراع العنيف.
إن التجربةَ اليهوديةَ أعطتنا مواداً واضحةً مكتوبة لكيفيةِ التشكل والنمو للبناء القامع العنيف، ثم للانهيار الداخلي الذي سيكون من فعل غزاة آخرين لليهود فيما بعد. وقد بينتْ التجربةُ كيف أن سياسةَ القبائل الساعية للسيطرةِ على مناطق قبائل وشعوب أخرى تعتمد على القوة الدموية، وهو عنفٌ تصورهُ بشكلٍ ديني مقدس، كما تُظهرهُ صورُ الإلهِ المؤسسِ لمثل هذه السياسات، فتلك الصورة الألوهية الراهنة وقتذاك هي المشكلة للعنف، لا أن البشرَ وهم الكهنة والأمراء الكبار هم الذين يصيغونها في لحظة سياسية صعودية لمشروعهم السياسي.
إن الأديانَ القبليةَ تقومُ في المشرق على العنف لأنها تطرحُ التوسعَ وتشكيل دول فاتحة، فيما أن الأديانَ المدنيةَ تقومُ على خلاف ذلك، عبر الدعوة والحوار.
اليهوديةُ شكلٌ مجسدٌ لذلك، ولهذا حالما غدتْ القبائلُ اليهودية قوةً عدديةً كبيرةً وهي تنزحُ من مصر مرعبةً المصريين من تناميها هذا، توجهتْ نحو مناطق الفراغ السياسي، لكنه لم توجدْ مناطقُ فراغٍ، لأن الأرضَ ممتلئةٌ بالشعوب:
(اسمعْ يا شعب إسرائيل. أنتَ اليوم تعبرُ نهرَ الأردن لتدخل وترث شعوباً أكثر وأعظم منك.. فأعلمْ اليوم أن يهوه إلهك يعبرُ أمامك كنارٍ آكلة. هو يدمرُهم ويخضعُهم أمامك، فتطردهم وتبيدهم سريعاً كما علمك يهوه)،(التثنية 9: 1 – 6).
من المؤكد إن هذه الصياغات العنيفة هي صياغاتٌ تاليةٌ عن التجربةِ القبلية اليهودية التوسعية، والتي تمتْ بذات الأساليب المروعة، وهي أساليبٌ كانت منتشرةً بين الدول والقبائل في الحروب في ذلك الزمان ولم يفعل اليهود سوى كتابتها وتسجيلها على أنفسهم، لكن أن تكون هي صياغاتٌ مقدسةٌ مؤبدةٌ عند المؤمنين بها حتى يومنا هذا، فهي التي تمثلُ مجموعةً من الإشكالياتِ الدينية والتاريخية.
لقد تمت فعلاً عمليات الحرق للمدن والإعدامات الواسعة للقبائل والرجال والنساء ونصوص التوراة تعطينا تفاصيل دقيقة عليها، ولكننا نقول بأن الصياغات الأدبية تمت في مراحل تالية ورغم إخضاعِها للتأنقِ في الكتابةِ لكن الحوداثَ الرهيبةَ ظلتْ محفورةً بين سطورِها مؤكدةً إياها حتى وهي مكتوبة بإسم إله.
إن الكهنةَ اليهودَ في مرحلةِ الأسرِ البابلي أو بعد ذلك يكتبون تفاصيلَ العنف، خاصةً في المراحل الكتابية الأولى:
(فنفخَ الكهنةُ في الأبواق، فهتف الشعبُ عند سماعِ صوتها هتافاً شديداً، فسقط السورُ في مكانه. فاقتحمَ الشعبُ المدينةَ، لا يلوي أحدُهم على شيءٍ واستولوا عليها. وقتلوا بحدِ السيفِ إكراماً للربِ جميعَ ما في المدينة من رجالٍ ونساءٍ وأطفال وشيوخ، حتى البقر والغنم والحمير)،(يشوع 6: 20 -21).
الكهنةُ والشعب المخدر بالشعارات الدينية، علاقةٌ تاريخية قديمة بين منتجي النصوص والممسوسين بها، وإستخدام الموسيقى وأدوات التأثير النفسي الحربي والشعارات والشعائر، كلها بغرضِ القيام بالعمليات الحربية الإبادية للخصم، لتنمو العملية السياسية وهي تحرقُ الأعداء.
تسبق العملياتَ الحربيةَ الجوانبُ العباديةُ، فهي المقدماتُ الضروريةُ للتخديرِ والتمكنِ من تحويل البشر من كائناتٍ مسالمة إلى كائنات وحشية، ولهذا فإن كلَ جماعةٍ تصنعُ أدواتها العبادية المميزة، والجماعةُ اليهوديةُ أثناء الخروج من مصر إحتاجتْ لسنوات عديدة لإحداثِ عملياتِ الغسل للعبادات السابقة وإحلال العبادات الجديدة، وجعلها تحوطُ بالبشر في كلِ ناحية، غير قادرين على الإفلات من جزئياتها الكثيرة في الصلواتِ والأحكام والفرائض الإنسانية والطقوس، بحيث تنشىء العقيدةُ سياجاً ملتفاً حول الكائن البشري، توجههُ نحو الخضوع للكهنةِ ورجال الدين والأمراء العاملين لخدمةِ أهداف سياسية معينة.
وأخذت العقيدةُ اليهودية المصاغةُ في فترة الخروج مناخَ الزمن العبودي المطلق، ويتجلى ذلك في صورة الإله المهيمن الكلي في هذا الزمن، الذي هو سيفٌ وبرقٌ وصواعق من السماء، هو روح القبيلة التي فقدت قدراتها العسكرية وتمت عسكرتها، وخلق الأناشيد الحربية فيها، ومناخُ العبودية المطلقة جاء من الحكومات السائدة وقتذاك، حكومات الفاتحين الشرسين وإبادة الخصم وتحويل الشعوب إلى ارقاء.
ومن هنا عملت المسيحيةُ على كسرِ إيقاعِ هذا العنف الوحشي، وجاءت الأناجيلُ متفرقةً متعددةً مختلفة، لتعارض الغزو والحروب والعبودية المطلقة فتؤنسن السياسة، لكن مسارها التاريخي قاد إلى هيمنة الإمبراطورية الرومانية عليها، ثم دُمجَ العهدُ القديم(التوراة وكتبها) بالعهدِ الجديد وهو الأناجيلُ المُعترفُ بها من قبلِ كنيسة روما. فبقيتْ الأقسامُ العسكريةُ اليهودية المفعمةُ بأجواءِ المذابح والعنف الوحشي في الكتاب المقدس المشترك، وغدت تلك الأقسامُ مادةً ثقافيةً مبجلةً لدى الملايين من المسيحيين خاصة وعلى مر العصور، لأن اليهود يقدسونها من باب أولى، وهو أمرٌ شكلَ الثقافةَ الاستعمارية المشتركة فيما بعد، وغدا العنف ضد الشعوب في العالم الثالث.


July 26, 2024
«لعبـــــة الرمل» قصة قصيرة : كتب ـ عبـــــــدالله خلــــــــيفة
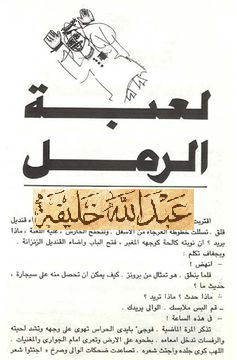
اقتربت الاقدام وارتعشت قرب الباب، فيما تراقصت اضواء قنديل قلق. تسللت خطوطه العرجاء من الاسفل. وتنحنح الحارس. عليه اللعنة، ماذا يريد؟ ان نوبته كالحة كوجهه المغبر.
فتح الباب واضاء القنديل الزنزانة.
وبجفاف تكلم:
ــــ انهض!
قلما ينطق. هو تمثال من برونز. كيف يمكن ان تحصل منه على سيجارة، حديث ما؟
ــــ ماذا حدث؟ ماذا تريد؟
ــــ قم البس ملابسك. الوالي يريدك.
ــــ في هذه الساعة!
تذكر المرة الماضية. فوجئ بأيدي الحراس تهوي على وجهه وتشد لحيته والرفسات تدخل أمعاءه. بطحوه على الأرض وتعرى امام الجواري والمغنيات. اللهب كوى جلده واجتث شعره. تصاعدت ضحكات الوالي وصرخ: “اجتثوا شعر صدره أيضاً!”. تناول ثوبه. لو ان القيود تنكسر، لو ان الألم ينزاح، لو ان الأرض تقف تحت قدميه والجواري الضاحكات يختفين من دائرة اللهب، وتبدو أرض القرية قادمة كأن خيلا تعدو اليها، وينفتح الرمل عن بساتين. لو ان الألم ينطفئ والنار..
وتثاقل السير امام الحارس. صعد السلم وارتقى الى الارض. هنا ثمة نسمات منعشة تقبل الوجه بحنو، وأشجار الدفلى تشيع رائحة مخدرة في الجو. النجوم تنتشر في مساحة شاسعة. نقط مضيئة هائلة العدد تترامى في كل اتجاه. هل كانت السماء من قبل هكذا؟
وادخله الى المجلس.
كان الوالي غارقاً في مقعده يحدث رجلا معمماً. تسربت البرودة اليه. ارتعش ووضع يديه بين فخذيه. على البساط، قرب قدمي الوالي جلست مغنيتان، احداهما احتضنت عودا في صدرها. ان وجهها الاسمر صارخ بالفتنة. تطالعه باشمئزاز ورثاء. انتبه الى الوالي الغائب مع سميره في حديث خافت، وكانت يد المغنية تداعب العود، بينما دف خجول يحجل في المكان. العازفة تطالع الارض بنظرة غريبة. ان نظرتها قرب قدمية وعلى السلسلة الملتوية كالافعى.
نظرة ليست كنظرة امي، الجالسة بين الدخان، التي تحمل حزم البرسيم والخشب، وثوبها الاسود المنشور، اذكره، كيف لي ان انسى؟ المغسول بالعرق، ونظرتها حين جروني امامها، على التراب والحشائش، اذكرها، الوالي غائب مع صاحبه الشيخ وفجأة ضحكا، وكان بكاء الاوتار يوقد نارا، وضاع صوت المرأة وظلت النظرة جاثمة قرب الأفعى.
والتفت اليه مبتسما:
ـــ ها قد جئت اخيرا ايها الخارجي.
اية لعبة يعدها لي؟ وتسلل ببصره الى الباب والنوافذ. لا يظهر أي اثر للحراس أو الانصال. وتمعن فيه الشيخ الذي أفرغ من زجاجة مليئة في كاسه، ووضع فيه قطعة ثلج.
ــــ هل انت هنا ايها الرجل؟
شعر بالانزعاج للسؤال، القاه بحدة وكانه يسحبه من قيده اليه ويمسكه من لحيته. والتمعت عيناه ببريق عجيب وابتسم! ربما كانوا ورائي الان، والتفت، ولكن لا شيء.
ــــ نعم، منذ عشر سنين.
عشر سنين يا اولاد الافاعي وانا بين الصراصير والزواحف. وهذا الغناء اسمعه انا تحت الارض، واتذكر الوان القرية، عشر.. ابتسم بانشراح، ووضع الشيخ كأسه في استراحة غير مرئية عند فمه، طالعه بشيء من الاهتمام، عشر لا اقل مع الظلمة، وحين جاءت امي تحمل خضارا طردتموها، اذكر، اذكر جيداً، وعريتموني في هذه القاعة وكانت الخمرة ضباباً، وكان الشراب والرائحة واللهب، ونظرات الجواري والخصيان، اذكر ضحكاتهم واللهب يحرق شعري وجلدي, ليلة اخرى تتسللون فيها، وامي حين جاءت تحمل خبزا القيتموها خارجا..
ــــ مضت عشر سنين على ضيافتك حقا؟!
ماذا تريدون ان تفعلوا بي؟ هيا تسلوا بسرعة.
ــــ أنظر يا شيخ كيف تجري الايام!
«شطف» الشيخ كأسه، وكانت عيناه الكبيرتان تحدقان بسرور.
ــــ نعم، نعم كأنها أمس.
عشر والايام عجلات من حديد تدهس الاصابع والرؤى، بين الجدران، في الظلام، للايام مذاق آخر، والقرية تغيب خلف الرمال، تغرق في الأصفر، وغاب الثوب الأسود واليد المعروقة الباكية، حلت النافذة الصغيرة العالية كأنها اسنان سمك القرش، وسار الوحش في اللجج.
ــــ انتبه اليَّ أيها الخارجي وكفال سرحاناً.
ــــ التفت اليه حقاً، قل حكمة أو دعني أرقد في الحر. انني ارتعش من هذا البرد المصطنع.
ــــ سوف اطلق سراحك الآن حالا. هل تفهمني؟
حدق فيه جيدا، ليس جادا ابدا، لعبت الخمرة..
ــــ لا افهمك.
ــــ ألا تفهم: الحرية! ستخرج في هذه اللحظة الى الصحراء وتمضي الى قريتك. لن يمنعك احد تجري وتجري حتى تصل قبل شروق الشمس.
أصغي الى رنة الخمرة في صوته، يهذي ويطلق فقاقيع من الوهم، بالونات ملونة، والأوتار ترتعش والمرأة تدندن والدف يرقص والشيخ تتجه أصابعه الى شعر المرأة المحدقة في الأرض دوماً. انها عمياء كالكلمات والفقاقيع ورعشة الخمرة وأصابعه..
ــــ انك ترتعش. ماذا بك؟
حر؟ أسمعي يا أمي صوتي، أفتحي الباب، في الليل اخطو اليك، متقلدا ضربات الافاعي والاشواك… تتقبلني الصحراء اخيرا وتدفعني الى طرقاتك البعيدة.
ــــ هل اصبت ببرد؟
ــــ كلا.
ــــ انه الاحساس بالسعادة الغامرة. انني اقدر مشاعرك المتقدة في هذه اللحظة. ولكن قبل ان تتمادى في خيالاتك احب ان انبهك الى ان ثمة شرطين بسيطين لتحقيق الامر.
وضحك الشيخ وتناول زجاجة لم تفتض بكارتها بعد.
ــــ الشرط الاول ان تشرب هذه الزجاجة كلها الآن.
أنه يعد لعبة مخيفة. ولكن انظر! زجاجة كاملة تجلس بكل عفافها وتنتظرك. وتطلعا اليك، ورمقتك المغنية ذات الوجه الفاتن وابتسمت. هل تكونين انت الشرط الآخر؟ توقفت العمياء وكأنها ترهف الى دقات قلبك أم هذه؟
امسك الزجاجة بقوة، ليكن ما يكون. فتحتها، وطالع مياهها المتألقة، وتنسم رائحة المزارع المشبعة بالندى، وتمايلت ضحكات الاصدقاء مع تراقص سعفات النخيل، وانفتحت دروب القرية للهمس والشعر والخطى، ودفق سائل اللؤلؤ فاحس ببرودته وعذوبته ومرارته. شعر بعروقه تنتفض ووجهه يشتعل وضع الزجاجة وقد تحولت الى جثة. جرت في مسارات جسمه مئات الاحصنة والثيران. واخذ يضحك ويضرب فخذيه بيديه ثم يشير الى وجهه. ابتسمت الجارية واراحت العود على البساط.
وتكلم الوالي:
ــــ والشرط الآخر هو أن تصل الى اية قرية قبل طلوع الشمس، واذا حدث ان عثرنا عليك في الصباح وانت هائم في البرية تقتل قتلا…
تراقصت الكلمات واتسعت القاعة، والمتكلم يدور ، والصمت مرهف ، والمتكلم يقترب ويبتعد لكن الصحراء تتضح، حبة رمل تسقط، وتسقط حبة اخرى، رمل، رمل وانت تجري في الظلام وكل الطرق مفتوحة، تجري ولا جديد، رمل، رمل، يمتد ولا شرطي يسأل، وتجري وكل الطرق مفقأة العيون، وشعر بالتعب والغثيان وود لو يجلس ويعد قدمية للرمل، تجري وتأكل المسافات…
ترنح على الأرض، سيتقيأ خارجاً.
ــــ ماذا بك؟
ــــ انني لا اصدق.
والتفت الى الشيخ.
ــــ أرأيت كيف صرعه الحلم؟!
ضحك الآخر ثم دفق كأساً آخر في جوفه.
ــــ لا تغامر ايها الخارجي. اكتف بالزجاجة التي سيبقى اثرها أياماً.
ــــ انني اقبل الرهان.
ــــ هل فكرت قليلا بالصحراء وامتدادها؟ ان المسافر يقطعها في ثلاثة أيام مشياً على قدميه.
انك لن ترى على مدى البصر في النهار اية نخلة، فما بالك في الليل والدروب مقطوعة؟ ولم يدر تماما، هل هو يسخر منه؟ لكنه سمع صوت امه يتجسم وينبض فوق الرمل، واختفت بقية عبارته. نهض وأحس بالقيود تأكل لحمه. ستتكسر الظلمة أمامه. اذكر الظلمات الطبقات المتكدسة، أذكر تنكة البول القاطنة عند رأسي، والنساء العاريات، والزجاجات والخطوط التي لا تنتهي والعلامات، اذكر جيدا. سمع الوالي يأمر باطلاق سراحه. الرجل يقترب ويفتح القيد ويحس بأن شيئا منه قد سقط. يقوده الحارس الى الباب، يلتفت الى المغنية الجميلة ويرى عينيها تلمعان ووجهها يتألق. كم حلم بتقبيلها! نظر الى المكان بكره.
قبل ان يخرج قال الوالي:
ــــ تذكر جيدا، اذا وجدناك وفي يدك قبضة رمل تقتل قتلا..
وجد نفسه خارج السور، في الصحراء، وحده، وليس ثمة شرطي.
جثم على الرمل. تقيأ كل الفوران واطلق الخيول لتجري في البرية. رفع رأسه وشاهد النجوم مزهرة بالضياء، مشيرة الى كل الجهات.
حقا وحده. العود يضحك ويبكي الآن على صدر المغنية، لن يرجع ثانية، سيجري، يحرق هذه الكثبان ويمضي شرقاً.
تعالي ايتها الصحراء انتهى عهد الجنون. الشيخ يضحك ويدس اصابعه بين ثديي المغنية العمياء. كيف سيقودها الى الفراش وهي بهذا الاعياء؟ والوالي ينتظر الصباح ليضحك فوق جثتي. لن تراني مرة أخرى. تعال ايها الرمل، اطويك بعالمي، انفيك بنفسي.
تعال بيننا قتال ضار، تعال…
وتآلف الظلام معه. رأى طريقا متقطعا الى قرية قصية قصية. توهج الرمل امامه وشع بالحبور.
تكلم وقال: خفف الوطء قليلا. انت تقتل نفسك بهذا الجري. أما ترى كيف امتد الى كل مكان، أما ترى عالمي الشاسع وانت كنملة عرجاء؟
رأى شيئاً جاثماً كخيمة كبيرة. سيأتي ويكبر حتى يحيله ثانية الى كومة تافهة.
هل تذكرني ايها الجبل؟ هل تذكر الفتية المحاصرين بالخيول والسلاح؟ مرت سنوات كثيرة على لقائنا الاول. وها انذا لم انسك وكنت في قبوي اتذكرك دائما واحلم بالصعود الى قمتك.
أكبر ايها الجبل، اكبر. الرمل الضئيل يزاداد ضآلة قربك، وأنت تنمو وتعلو حتى تملأ الرحب. ولكنني سأحيلك الى تل صغير بعد لحظات، ثم أزيلك تماماً. اضحك على وهمي ولكنك ستصدقني بعد حين.
فجأة انبعثت صيحات ذئاب. رتجف وانصت الى نزاعها حول جثة ما. وقد يكون رجلا آخر سار من اجل مدينته. انها تأكل بضراوة وتتقاتل.
سار بهدوء كلم الرمل ان لا يصدر صوتا. كلم الجبل ان يسمح له بالمرور.
صعد وتوغل. هواء القمم له نقاوة السحاب. ارتفع واملأ رئتيك بعبير البساتين القادم من الفجر. امي تتقلب في فراشها، وتنتبه الى صوت القادم. تشعل المصباح وتنهض. ليس سوى الاغنام تثغو. الكون غرفة مظلمة فمن ينهض فيها ويشعل.. تلقي نظرة على الصغار الذين كبروا. تسمع الشمس وهي تخطو على مدرج الظلام. تعالي يا بساتين.
وانحدر وانحدرت حصى. اختفت حمحمة الذئاب وامتدت البرية ظلاماً وألغاماً. بغتة رأى قدميه تغوصان في وحل عميق. الأرض تريدك الآن. تعال، تعال، أدخل فيها. امسك صخرة فكان ترابا، واشتد الضغط من أسفل واطبق عليه الاخدود وراح يزدردة. امسك صخرة اخرى فكان ضبابا. رمل ووحل ووقت ضائع. امسك صخرة ثالثة وتشبث. تعالي يا بساتين، اذكر الاقبية جيدا والجوع والرحلة الغائصة في الطين، اذكر الاصدقاء الغائبين وراء النخيل والصمت المطبق. اذكر، اذكر، هذه الصخرة تعانقني وترفعني.. اركض، اركض، ذئاب، والمسافة تكبر، والجبل سينطلق في الغد، والرصاص سيستقر في رأسك، اركض، النفس يتقطع، الظلام في كل الجهات. الرمل يظهر ولا اثر لنبات. هيا لا تتوقف آه، تعبت.
أمش الآن قد تصل وقد لا تصل. رمل. رمل. اليوم رمل.. آه، سأنهار هنا.
سقط. باردة هذه الحبيبات. ادخل يدك في جيوب الرمل فلن تجد شيئا. أليس ثمة قطرة ماء؟ قابل السماء. لم تزل القناديل متدلية، والارض فراش بارد يصلح للنوم الى الغد فحسب.
تفتح بوابات القرية، وتأتي اليك الطرق، البيوت القديمة ترفع النقاب عن وجوهها، الدكاكين، المخبز الذي طالما وقفت عنده وشممت رائحة الخبز ودققت في وجوه الصبيات الضاحكات. تلمع عيونهن من الفرح والنار، وتمضي الحقول والينابيع وترى الصغار يجرون بين المزارع يصطادون الطيور والثمر. القرية تنهضك. لن تراني ثانية ايها الوالي. سأصل. وانطلق وجرى وجرى. يمتد الرمل مجددا، بحر لا شاطئ له، ويجري، معي أمي، واخوتي الكبار، التنور والحقول والمدارس والعصافير وضحكة الفتاة التعبة واحلام النجارين ولافتات الطريق وابتسامات العرائس، معي، الندى والطائر، وكانت النساء يشيعنني من نوافذهن، ووقف الفلاح العجوز في حقله المنعزل واهداني نظرة وكلمة، معي، الآن الرمل، يجرني الى اعماقه واغوص، معي، الآن التعب والألم، ووقف الاطفال في الطريق وتركوا لعبتهم وحدقوا حتى سرنا بعيداً وساروا، كبروا، الآن، في الرمل، وحين احضرت امي خبزاً طردوها خارجا، وحين جلبت زيتوناً وفاكهة ألقوها على الرمل، ودقت بوابة القلعة الكبيرة وصاحت: ادخلوني. ادخلوني. بقيت الى المساء، ورأيتها في الصباح. ادخلوني. ثم سارت باعياء كشجرة كسرتها عاصفة. وما انبت الرمل شيئا. ولما بكت على السور وقالت: ابوه.. ادخلوها. واحتضنتها. القرية هنا والارض وخبز المساكين.ابوك قد مات. وسارت في الليل وبقيت وحدي مع الفئران.
انشقت رئته. وقف بمهل. بصق شيئاً حاراً لاذعاً. لم يطالعه وسار. وبدأت السماء تتلون بألوان جديدة، يبدو ان الفجر قريب. لا تقف الآن ولا تتمهل. اجرِ، اجرِ، اجرِ، اطحن الرمل وحوله الى زهر، ابوك قد مات في الارض، اخوتك صغار. سأعمل فيها. لا تبكي يا امي. هل سأكون هنا الى الابد؟ والصغار يكبرون.. لم يمت في الرمل؟ اجر لا تهدأ، الافق يتلون وعما قريب تظهر الخيول. يقف فوق رأسك. تموت موتاً. ليس في يدك قبضة رمل فحسب حتى في احشائك. انت لا تستحق سوى الموت ككلب. ماذا تنتظر؟ هل تتوقف في منتصف الطريق؟ وترنح من اعلى الهضبة. تدحرج مع الحصى والدم حتى وصل السفح وتعلق في شجيرة شوك. جاءت النهاية أخيرا. بين يدي الزرع الاصفر. بين الشوك والرمل جسر من الوحل.
بصق دماً ثم حرر يديه من القيود وكسر الاغصان بصبر حتى خرج.
اصعد المنخفض. هنا رائحة نتنة. سينتشر الفجر قريبا في الصحراء والرصاص. ولكن لا تتوقف.
مضى، احس بأنه لن يستطيع بعد دقائق ان يسير. سينهار ويتلاشى. كل خلية تنبض بالتعب. كل خطوة سير على لهب. وتمتد الصحراء بلا توقف، وتطول، وتخرج جهات جديدة وآفاق تلد رملا.
سيضحك الوالي فوق رأسي. النشوة تكون قد غادرته، وانتبه الى الحماقة التي ارتكبها. حمداً لله واثنى عليه. لم يصل الكافر الى القرى فيذوب فيها. حمداً لله الذي وضعه تحت قدمي ميتاً أو شبه ميت. عندما يأزف اجلهم تتعطل كل الساعات.
يبدو شيئاً معتماً في طرف الافق. ويلمع ضوء! ولكن ليس في النفس بقية، ورياح الفجر بدأت تدندن. امض. هنا لحظة الاشتعال. أخرج كل المخزون واسحق الرمل سحقاً. اقتله قتلا. ها قد سقطت ولكن انهض. تعالي الي ايتها البساتين، بل لا تأتي، تخلقها، والجبل تخفضه، تعالي الي ايتها الدماء، والرمل يبلعني، ترنح في الحقل ومات وحملت هي الفؤوس والمناجل، لا تأتي اليك القرى والبساتين والمحاجر، وكبر الصغار وتعلموا ابجدية الكتابة في الارض وارسلوا اليك الشموع والفواكة، ويقترب الأفق ويتألق، صحراء، صحراء، واسربة الحدائق تنتشر في كل مكان، رمل، رمل، وخيوط الليل تذوب في ماء النور، ويبتلعك الرمل وتصغي الى همهمة التراب وخفقان قلب الصحراء. ستنهار هنا. الاقدام والخيول والضحكات ولا حول ولا قوة الا بالله والبنادق المصوبة وقبضة الرمل في الاحشاء..
الشمس تفتح النافذة وتطل.
زحف على الارض! المغطاة بالسكاكين الحجرية. ليس سوى هذا الحقل طريقاً للحقل الصغير المنعزل. القرية للمتنزهين. وتدق خيولهم على رأسك. وجدناه وليس في يده حتى قبضة رمل. خطوات وتحضن الام والنساء والصغار وتستنشق عطور الحقول وتفتح بوابات الاصيل وجلسات الغناء وتتخطى الرمل. ابعدي يا صخور. ابعدي يا قبور. تنهض وتسير، من يعرفك الآن وانت انسان آخر، وانت تسقط على حافة الحقل وتغمس يدك في الماء وتلمس الورق المغسول بالندى؟
* معتقل سافرة
* كتابات: أبريل – 1979
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموعة الرمل والياسمين (قصص)، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1982.
* (القصص: الفتاة والأمير ـــ علي بابا واللصوص ـــ شجرة الياسمين ـــ العوسج – الوجه ـــ الأرض والسماء ـــ المصباح ـــ نزهة ـــ الصورة ـــ اللقاء ـــ لعبة الرمل ـــ الأحجار ـــ العرائس ـــ الماء والدخان).
July 24, 2024
وطــــن للثقافــــة وثقافــة للوطــن..
إن الثقافة الوطنية في عالم الكاتب المبدع والمفكر البحريني الجسور عبدالله خليفة جزء من مشروع فكري كبير وواسع يجوس أعماق وآفاق محطات ومنعطفات وتحولات وصراعات واشتباكات حدثت وتنامت وتداخل واحتدمت في أرجاء وأصقاع الفكر العربي والإسلامي القديم والمعاصر.
ولعل الرؤية التقدمية المستقلة الثاقبة والفاحصة والشاخصة لدى كاتبنا الوطني المفكر عبدالله خليفة في هذه الثقافة المشروع، لا تدع مجالاً للحديث عن الرأي الانطباعي أو الحديث عن التجربة الإبداعية بمعزل عن مشروعه الفكري أو الوقوف عند سيرته الذاتية بمعطياتها التقليدية الأفقية الناجزة أو الوقوف دون خوض في مختبراتها النضالية والصراعية الشاقة، إنه يتماهى فيها دون هوادة وكما لو أنه جبل بذاتٍ قُدّت من فكرٍ منذ الصنيعة الأولى لخلايا وعيه.
وهكذا وعي ثقفن ذاته، لا يمكن أن يكون سوى مشروع، وهكذا مشروع لا يمكن أن يكون سوى أنشودة أنغولية تنشد الحرية وتشدو بها.
هو عبدالله خليفة الذي مذ فطنت خلايا ذاكرتنا به وهو المهيأ لحوار ساخن لا يهدأ أواره وهو المعترك في الاشتباكات والمساجلات الفكرية العميقة، هو المسكون بالهم والوطن والحلم والفرح والأمل، هو المنتصر لكرامة الإنسان وكبرياء الفقراء والكادحين والمسحوقين، لا يهادن ولا يساوم ولا يجامل، شامخًا باسقًا كنخيل دلمون، نضرًا وإن كان وحيدًا كزهرة البيلسان، تشتد أغصانه وتخضر كلما كابدته معاناته ومعاناة شعبه ووطنه، يمضي على قلق وهو ينافح عن فكره ورأيه كالرمال المتحركة، فضاؤه الفكري مساحة للجدل والخلق، ووقته زمن غابوي كثيف للإنتاج والإبداع.
منذ استباره أعماق بحر الرواية وهو لا يكف عن البحث عن اللآلئ المفقودة أو ربما عن فردوسه المفقود، عبدالله في سعة البحر وفي لججه وفي أعماقه وفي كل تفاصيل
وتضاعيف وتقاسيم الوطن، في مدنه وقراه، في أساطيره وتراثه، في دهشته الساحرة والمسحورة، في ينابيعه العطشى، في ألحان شتائه الشجية وفي أغانيه المائية والنارية، في نسائه الباذخات وفي نسائه الشامخات الشاهقات.
ما الذي لم يكتبه عبدالله خليفة عن الوطن؟ لا شك أن المخيلة مكتنزة بقصائد لم تنشد بعد، كأقلفه الثمانيني الذي أثار جموح اللغة والفكر في الثالثة بعد الألفين، وكمشاريعه الفكرية التي تنتظر مصداقية شفافية العصر لتنجلي وتتجلى في سماء الفكر العربي.
هو عبدالله الذي ما أن تغيب عن البال شاردة إلا هو واردها، وهو الذي يرى في الفكر والفكر وحده، زاهدًا من عمّده بالكرامات والجوائز والتحافي والتزكيات المرسمنة، هو القاريء للحياة مثلما هو السابر في الفكر، فحياته وفيؤه وظله أصدقاء وعمال بسطاء، ومن فكره يجود ولا يبخل، ومن وحي ورحيق صحبه ومعينه يتجسد رواية أو قصة أو دراسة أو مسرحية أو مقالاً.
الثقافة المشروع لدى عبدالله خليفة وسط هذا المشغل الحياتي الفكري المركب، ليست آنية أو طارئة أو عابرة، هي أزمنة تتداخل ورؤى تتصارع ومطاليب تتمأسس وتاريخ حافل بالمكائد والدسائس والنضال والمواجهات العنيفة الضارية، هي قراءة للراهن والمستقبل، قراءة لم تعقها جدران الزنازين الرطبة وظلامها الموحش الموارب الفاتك، ولم تغوها المغريات.
الثقافة النيرة المتقدمة هي أولى الأولويات الفكرية لدى عبدالله خليفة، فمن يزعم بأن الثقافة آخر الأولويات في مشاريعنا الوطنية، لا يدرك في الشأن السياسي سوى أخماسه وأعشاره، ولنا في نقيضه أسوة بذخائر عبدالله خليفة الفكرية، ولو أحصينا نتاج عبدالله خليفة الفكري والإبداعي كمًا ونوعًا وتميزًا لرأينا ـ عبدالله ـ لا يزال شابًا يافعًا فارعًا يتحدى الزمن وكما لو أنه يشكله كيفما يشاء ووقتما يشاء، إنه يرحل ويغادرنا وفي حوزته من الروايات والقصص القصيرة قيد الطباعة والنشر ما يربو على الخمسة عشر رواية وعشر قصص قصيرة، وذلك بعد أن أصدر ما يربو على السبعة والعشرين رواية وعلى السبعة مجموعات قصصية قصيرة، وعلى الستة كتب في مجال الدراسات النقدية والفكرية.
متى يسترخي عبدالله خليفة وهو الذي ينشد في التياذه للفكر شاغلاً ومنشغلاً أجمل منتجع للاسترخاء؟ أو بعبارة أكثر استرخاء، يبدو أن عبدالله خليفة لا يسترخي إلا حينما يسترخي شاغلاً ومنشغلاً، لذا حين غادرنا، جعلنا مشغولين ومنشغلين بنتاجه الذي صدر والذي لم يصدر بعد..
للثقافة الوطنية جذور وللوطن جذور ولعبدالله خليفة جذور الثقافة والوطن..
عبدالله خليفة فكر للوطن ووطن يفكر في مساحات الوطن الأوسع..
تمضي على رحيله ست سنوات ولا يزال في الوقت متسع لإبداع وفكر لم يصدرا بعد.. متسع لحوار لا ينتهي..
عبدالله خليفة.. وطن للثقافة وثقافة للوطن..كتب : يوسف الحمدان
July 17, 2024
(رأس الحسين) رواية عبدالله خليفة
كتب : مقداد مسعود
2024 / 7 / 17
(… وطعن الحسين عليه السلام، سنان بن أنس فصرعه، وبدرَ إليه خولي بن يزيد الأصبحي فنزل ليحتزّ رأسهُ فأرعد، فقال له الشمر: فتّ الله عضدك مالك ترعد؟
ونزل الشمر إليه فذبحه، ثم دفع رأسه إلى خولي بن يزيد فقال أحمله إلى الأمير عمر بن سعد… وسرّح عمر بن سعد
من يومه ذلك وهو يوم عاشوراء برأس الحسين عليه السلام
مع خولي بن يزيد الأصبحي وحميد بن مسلم الأزدي إلى عبيد الله بن زياد عن الشيخ المفيد، عن الكلبي عن المدائني)
✤
الكتابة الإبداعية عن ملحمة الطف تتحكم فيها الوثيقة الموجودة في كتب التاريخ، قبل سنوات توقفت عميقا عند مجلد (الملهوف على قتلى الطفوف) لابن طاووس وكذلك موسوعة الباحثة بثينة بنت حسين (الفتنة الثانية ..) وكتبتُ عنه مقالة منشورة في المواقع الثقافية 15/ 8/ 2022 وأطلعتُ أيضا على (الحسين في الفكر المسيحي) للكاتب أنطوان بارا وكتاب( الحسين الوسيط / دراسة تحليلية بنيوية لواقعة كربلاء) من تأليف تورستن هايلين. وقبل هذه الكتب قرأتُ في سنوات الحصار، (تراجيديا كربلاء) للكاتب إبراهيم الحيدري مستنسخا. وفي 2008 حين كنت مسؤولا عن البرامج الثقافية في إذاعة الملتقى ومع شهر محرم قدمت من اليوم الأول حتى اليوم الثالث عشر وبتوقيت الرابعة عصر حلقات بعنوان (تراجيديا كربلاء).. ولا يمكن نسيان كتاب عباس محمود العقاد ( الحسين سيد الشهداء) ومسرحية الشاعر عبد الرحمن الشرقاوي (الحسين ثائرا) و(الحسين شهيدا) وفي 2022 ومن خلال ملتقى جيكور الثقافي كانت لي محاضرة عنوانها(التسلسل التاريخي لمجالس العزاء الحسيني)
أما موسوعة السيد كاظم القزويني طيب الله ثراه (زينب الكبرى من المهد إلى اللحد) التي تبلغ 620 صفحة فتحتوي مرحلة تاريخية وتهبنا جهدها الذي لامثيل له حول الفاجعة وقد صدرت الموسوعة عن دار المرتضى بيروت/ 1420 هجرية.
✤
عن كل هذه الكتب أقول أن مساحة الإبداع فيها أوسع بكثير من المساحة المتاحة للنصوص الأدبية عن فاجعة الطف. هنا يكون الكاتب مقيدا بالمراجع التاريخية ويتحول النص المكتوب إلى نص تسجيلي ومهمة الأديب هي استقراء النصوص التاريخية ثم التقاط ما يوائم النص المسرحي أو الروائي. وهي محاولات مصحوبة بجهود كبيرة. أما في الشعر فحرية التعبير واسعة جداً فالجهد مشبع بالمخيلة المدججة بالكنايات والاستعارات كل هذه الحقول تقوم بتدوير السرد، مِن التاريخي إلى إبداع يحتوي محموليّ الماضي المستبد وعلاقته بالراهن الملتبس الذي نكابد منه كل يوم.
✤

في روايته ِ( رأس الحسين)/ط1/ 2006/ الدار العربية للعلوم/ بيروت، حاول الروائي عبدالله خليفة أن يجترح تعادلية بين الوثيقة والمخيلة فجعل الرواية تبدأ مع نهاية فاجعة الطف، وتوجه الجيش الأموي والسبايا إلى دمشق.
ومحور الرواية يقدمه لنا الروائي مع الصفحة الأولى من خلال محاورة تجري بين أثنين من جنود الأمويين (انتزعتْ يداه الرأس. احتضنه في صدره. ارتجف قلبه ُ فجأة . حدق في بقية الجثة ورأى نافورة من دم. تدافعت الأيادي إليه. دخلت الأظافر وجهه، اندفع بعيداُ وهو يصرخ فرحا: الرأس لي. صاح الشمر: أنا الذي قتلته ولي هذا الرأس الثمين! قال حمزة من موقعه : صار لي الآن، وغداً أرميه تحت قدميّ الخليفة وأفوز بالعطايا يا أو غاد/ 5) السطور القليلة هي محاورة بين قاتل الحسين وبين شخص اطلق عليه المؤلف اسم حمزة. المحاورة هي الخلية السردية الموقوتة ، وستكون بسعة (176) صفحة من الحجم المتوسط ومن هذه السعة السردية ينهض الفضاء الروائي..
وقراءتي هي قراءة منتخبة اشتغلت على شخصية الإنسان المهمش أعني الجندي الأموي/ مهرج يزيد ويمتلك السرد حيوية التشويق من خلال تحولات يمر بها الجندي حمزة، من الوعي الزائف إلى الوعي الثوري.. وسؤال حمزة الأول ينطلق من الصفحة : (تأمل حمزة بقايا المعركة بدهشة وتساءل : لماذا ساقنا الخليفة يزيد إلى هذه الأرض الترابية والإحاطة بهذه العائلة الصغيرة والجماعة الضئيلة؟! هذه الأسرة التي حاصرناها طويلاً وهي لا تستحق كل هذا الحصار العنيف !) وسؤالي كقارئ: هل طوعاً أم كرها شارك حمزة في الجيش؟ وهو يحتضن رأس الحسين ليلا يسأل نفسه (ما بال هؤلاء النسوة والأطفال لا يكفون عن البكاء؟ ألم يأمر قائد الجيش بعدم البكاء؟/ 9) وإذا سألنا من هو هذا الحمزة؟ يجيبنا السارد (هو جندي فقير يلتحق بجيوش المسلمين لكي يحصل على الغنائم) هنا يقترض الروائي عبدالله خليفة تقنية شبح الأب المغدور، من شكسبير في مسرحية (هاملت) ينعس حمزة ويرى فيما يرى النائم، هناك مَن يحدثهُ (ماذا تريد مِن الجيوش والحروب يا حمزة، ألست شاباً قوياً ومقبول الطلعة وتستطيع أن تعمل منذ الصباح حتى السماء؟ تستطيع أن تكسب كثيراً بالعمل /11).
هنا يتخذ الروائي عبدالله خليفة مساراً مغايراً في التعامل مع الوثيقة التاريخية فهو ينتج مخيلة ً تتجاور مع الوثيقة ولا تتماهى فيها، من خلال التحاور بين شخصين شاسع المسافة بينهما. شخصية خالدة لا تأفل شمسها هي شخصية سيد الشهداء الحسين عليه السلام، وشخصية رجلٌ مِن همل الناس اسمه حمزة ومن خلال التحاور بين الحين والآخر يزداد حمزة وعيا بما يجري وينتقل إلى صف الحسين كما انتقل القائد في جيش الأمويين الحرُ الرياحي. مع الاختلاف الكبير بين القائد الرياحي وبين الجندي حمزة، وأكبر الفروق بينهما أن الحر الرياحي أستشهد دفاعاً عن ثورة الحسين أثناء موقعة الطف. لكن حمزة سيفهم الحسين من خلال الحسين أعني من خلال صوت الحسين وهو يناجيه، وقد أصاب الروائي حين جعل ثريا نص روايته (رأس الحسين) فهذا الرأس الثائر كان في حيازة الجندي حمزة، ولأسباب إنسانية محض كان الشهيد الحسين يحنو على الجندي الذي طمسوا وعيه وجعلوه يتصور أن هذا القتال لنصرة الدين الإسلامي. وهنا يأتي دور الحسين شهيدا في توعية الأحياء الميتين في حياتهم..
لنكمل الآن التحاور بين حمزة والحسين
(مَن يحدثني؟ مَن يتكلم معي؟
أنا الحسين أتكلم معك مِن هذه الرأس التي تحملها؟) سنلاحظ أن تحاور الحسين له منطق استدلي متمهل فهو يتعامل مع إنسان مِن همل ِ الناس. وحين يرتبك حمزة قائلا
(أعوذ بالله، ألا تكف أيها الوسواس الخناس من الحديث معي وأنا رجل مؤمن مسلم؟)
يكون جواب الحسين سؤالا: (متى صرت مسلما يا حمزة، بعد أن قالوا لك عن الغنائم
والأسلاب والنساء؟) ويكون جواب حمزة تساؤلا (كيف تريدني أن أكون مسلماً وأنا معوز، جيوش المسلمين تقدمت في كل مكان، وأنا شاب ٌ فقير ولا فرصة لي وهذه الجيوش تملأ جيوب جنودها بالمال) يسأله الحسين ( وهل المال هو الذي جذبك إلى الإسلام، أليس هذا مخجلا ً ؟ / 12)..
وهناك نوع آخر من التحاور العنيف بين الجندي حمزة وقاتل الحسين ومن خلال المحاورة نكتشف جهل حمزة بهوية الرأس، كما نكتشف شيئا من فطنته حين يخاطبه الشمر:
(أترك الرأس يا حمزة وإلاّ قطعت يدك !)
(لن أتركه.. لن أتركه!)
(قلت لك أتركه، ما أنت سوى فتى تافه وهذه الرأس لي، أنا الذي ضحيتُ وقطعتها
عن الجسد، أنا الشمر!)
(أرجوك يا شمر أنت رجلٌ ميسور وأنا فقير معوز، دعني أخذ هذه الرأس للخليفة ليعطيني مالا كثيراً) هنا تتضح سذاجة الجندي حمزة، فيرد عليه الشمر: (لم يتقدم أحدٌ إلى الرأس غيري، والجيش كله خاف!) وهنا تتضح فطنة حمزة حين يسأل الشمرَ(لماذا خاف الجيش كله مِن قطع رأس لرجلٍ أحاط به جيشٌ كثيف؟)
يجيبه الشمرٌ( لأن الجيش كله ُ جمعٌ مِن الجبناء، ليس فيهم رجلٌ شجاعٌ مثلي)
هنا يطلق حمزة صدمة التلقي في وجه الشمر حين يخاطبه( لا أرى فيها شجاعة يا شمر والرجلُ محاط بآلاف العسكر) ولأن الشمر يشعر أن منطق حمزة فضحه فيستعمل السيف ويهوى بسيفه على أصابع حمزة.. يضمد حمزة يده، بيده الثانية .الشمر القاتل السارق يتوارى.. في ظلام يبصر العباءات والنجوم والقوافل والسبايا حشد من قطع شمس ٍ ممزقة حشد من السيوف، غابة ٌ من الرماح، على صدر الحسين وصوت الحسين واضحٌ جلي:
( لا تتركني يا حمزة!
يتلفت وهو في كل ألمه، الذي أنغمر بالصوت الشجي الدافئ يبحث..
لا تتركني.. يا حمزة..!
من يتكلم هناك؟
أنا الحسين، أتحدث معك، لا تتركني أيها الفتى الطيب
أي صوت هذا، ماذا يريد هذا الصوت الغريب؟
لا تتركني يا حمزة أريد أن تحملني، لا أريد أن يلمسني هذا الرجلُ!
ما هذه الأصوات، كيف للظلام أن يتكلم!)
من هذا التحاور ستحل في حمزة الرؤية الجديدة حين يرى أجساد الجنود ملقاة على الحُصر والسجاد كأنها مرمية ٌ من السماءِ كأحجار صلدة مستكينة خافتة الحس والضوء (لم يرهم من قبل هكذا/ 14) وأصابعه لم تعد تؤلمه ويواصل حمزة صراخه
(سرقوا الرأس مني أيها الناس) والصوت الغريب الخفي الذي لا يسمعه سوى حمزة
يناديه (أبحث عني يا حمزة، أنا تائه الآن في الصحراء والعالم، أبحث.. عن..)
الأصوات تختلف، حمزة وهو يبحث عن الرأس الحسين( صاح بهم مفزوعاً باكياً)
(صرخ جعدة) جندي آخر (أضاف بصوت ٍ هامس: أتعرف صاحب هذه الرأس)
(نهره آخر: أسكت وإلا قتلونا) (صاح حمزة : لا أعرف شيئا سوى أنه هدية أعطاني إياها القائد..) ( صاحوا به جميعا).. (نهره الحراس) (علام هذه الضجة) نبرة هادئة (تعال يا غلام) في خيمة القائد (لم تكن خيمته فرحة أيضا) (فالنسوة الجميلات والعود والدفوف وأطباق الأكل الباذخة والرجال الندامى، لم تكن تصنع متعة ً في هذا الهدوء الغريب/ 17).. ربما نجد بعضا من الجواب في كلام حمزة كما يصفه السارد (تساءل حمزة في روحه الضاجة : مَن الميت الحقيقي يا رب؟! كان المقتول يتكلم بهدوء وفرح غريب! وهؤلاء الأحياء الممتلئون بالطعام والشراب كأنهم جثثٌ متعفنة !) وحين يسأل القائد حمزة َ : ماذا تريد يا حمزة؟ يخبرنا السارد عن ترجمة حمزة لنبرة صوت القائد (صوتٌ لم ينبثق من جسد كما أحس حمزة، بل من خرابة، بل من ثقب عميق غائر في الأرض وتخرج منه تنهدات الموتى وهي تتلوى مع الدود والعقارب!) تقابل نبرة صوت القائد، نبرة صوت حمزة (لم يخل عن هياجه) ثم تنتقل النبرة إلى هدأة الصوت الجواني( قال حمزة لنفسه ما بال هؤلاء القوم المنتصرون غير قادرين على الضحك؟ لماذا يبدو المنتصرون كأنهم موتى والموتى أحياء؟ لماذا تشتعل القناديل في البرية ولماذا يزهر العشب فجأة في اليباب، ماذا يحدث يا إلهي؟!/ 18).
هذه نقلة جديدة في مشاعر حمزة مشحونة باستغراب ما يجري، يكوّر مشاعره ويقذفها بوجه أمير الجيش
(يا سيدي إذا كان الفوز في المعارك لا يجلب الضحك فكيف يستطيع معتوه مثلي أن يضحك سادة القوم ويحوز على جواريهم؟) الوجوم الذي كان يطبق على وجه عمر بن سعد يستحيل ُ إلى غضب وحقد ثم يصيح مخاطبا حمزة ( قل لي ماذا حدث؟ أصدقني القول وإلاّ وضعتُ هذا النصل َ في حنجرتك) نلمسُ ونحن نقرأ الرواية أن تنويعات الصوت من خلال نبراته تتحكم بنسيج الرواية. أمير الجيش الأموي يصيح لا يتكلم وبصياحه يهدد حنجرة حمزة (وإلاّ وضعت ُ هذا النصل َ في حنجرتك) النصل/ الحجرة وليس السيف / الرأس.
وهنا يتماهى ذلك الصوت في حنجرة حمزة ولسانه ويشعر حمزة ليس هو المتكلم فقد (راح الصوت الغريب في روحه يتصاعد ويكاد يشق صدره) الجثة المقطوعة الرأس المرمية في العراء تشخب دما لا يتوقف، يروي العشب
الأصفر الذي انتشر فجأة وبشكل مخيف ثم تخاطبه الجثة من دون الآخرين (أين رأسي يا حمزة؟ أين رأسي يا حمزة..؟)
وحين ينتهي حمزة من كلامه يرى صدمة التلقي واخزة ً في وجوههم (أبصر حمزة وجوه الجميع كأنها غير مرئية، لم تعد ثمة رؤوس، هناك أكتاف ضخمة أو ناعمة أو عارية، ولكن لم تكن ثمة عيون، ولا جباه، وحتى القائد بدا في وقوفه كأنه يصل إلى الفراغ، كان رذاذُ لعابه يتطاير لكن لم يكن ثمة لسان ولا وجه 18).. بمرور الوقت والقافلة تقصد دمشق يتقدم حمزة خطوات ٍ جديدة ً في وعيه التراجيدي لثورة الحسين المغدورة( يحس ُ الآن أنه آثم في عمل ما، وشريك في جريمة لا يعرف عنها شيئا 25) وهو صادق في قوله عن نفسه( إنني لم أرسل سهماًـ بل أنا راوية هذا الجيش ومضحكه..) لكن تحولات وعيهُ تجعل منه الرواية الضد (.. لأروي كل هذه القصص وتسمع أشعار الحسين وزينب والعباس 27).
✤
يزيد حين يخبره احد العاملين في بلاطه بمقتل الحسين وعدم تراجعه، سيغضب ويزداد حنقاً حين يعرف(الجثة لم نعثر لها على أثر، كأنها سرقت، أو خطفها أشباح أو جن أو بشر فجأة توارت في الظلام 33) هذا الكلام ضمن حرية مؤلف الرواية في استعمال المخيلة ولا يحق لنا الاعتراض بل المخيلة تعطي للحسين استحقاقه الرمزي ضمن الرواية. ويزيد يهمه جدا وصول رأس الحسين إليه ليعنّف الرأس حتى ينطق الحسين فالطاغية الحاكم الأموي يعلم جيدا ً منزلة آل البيت عليهم السلام (لعل الرأس تتكلم وتطلب الغفران وتعلن الطاعة.. هم أهل معجزات لعلهم هكذا كما يزعمون فأستطيع أن أجبر الرأس على الطاعة.. وإعلان الولاء..) ولدى يزيد مقترح آخر( لعلي أضعها على طاولة كبيرة وعليها ستار وأجعل أحد ينطقُ وراءها).. وفي ص 38 يتقمص حمزة شخصية دونكيشوت (رجل على فرس هزيلة ناتئة العظام، كريهة الشعر، وهو يحرك عصاه ويقطع أشلاء الجنود الوهمية ويقف على الفرس التعبة التي تكاد تسقطه، جعل الأطفال يحدقون فيه مبهورين، فيقوم بطعنهم بسيفه الوهمي، ووضع عمامته على رأسه فأخفى أجزاء كبيرة ً من بصره، وكاد يسقط ولكنه تمالك نفسه وهو يقبض ُ على الهواء، والأشياء عائدا ً إلى موقعه على الفرس، وذهل حين سمع جزءً من ضحكة طفل صغيرة حبسها جبلُ الأشلاء والدموع/ 36).
هذه هي خطوة حمزة الأولى في التقرب من السبايا. هنا استعاد حمزة دوره القديم كمهرج في بلاط يزيد حيث كان يربطه ويفتح فمه ويدلق الخدم ُ الخمرة َ، سيل من المياه الحارة تشتعل في أمعائه ثم يدلق الخدم كمية من الخروع فيصير كرش حمزة مثل تنور الخباز والكل يضحك في البلاط وتكون مكافأة حمزة حماراً..!!
الآن يقع حمزة تحت سطوة تأنيب الضمير ويخاطب نفسه (كيف تركت يا حمار القصر بجواريه وملاهيه لتلتحق بهؤلاء الذئاب، البدو القساة الجفاة .. يبيعون دينهم بدينار/ 46)..
هنا يسطع صوت الحسين لينقذ حمزة مِن جلد ذاته بالتحاور المحجوب عن سوى حمزة، يخاطب الحسين (لو أنك تأخذني يا حمزة، لو أنك ترفعني من هذا النصل، وتجري بعيداً، نحو الحجاز، أو نحو أي بقعة ٍ نظيفة من الدم والحراب..) لكن حمزة من أجل تحقيق مطلب الحسين يشترط عليه الحسين( لو أنك تغدو جريئا، تصير نظيفاً.. تخطفني.. لكنك لا تزال جباناً تافهاً 48) اعترافات حمزة توجع الحسين وحين يسأله حمزة عما به يجيبه الحسين (أبكي عليك كيف تذل نفسك إلى هذه الدرجة./ 50) ..
✤
رأس الحسين تمرد على الشمر ولم يفز به حمزة وصار في حيازة الجندي الأموي هشام. لكن زوجته ترفضه زوجا حين تعلم أن يحمل رأس حفيد الرسول وحين يعرف الجيران يقتحمون البيت.. فيجدون الجندي هشام ميتاً ..
✤
يكتمل الوعي الثوري عند حمزة الراوية والجندي والمهرج السابق في بلاط يزيد، صار يحرض الناس على الثورة واصبح منشدا ً حزينا يلهج بمدائح آل بيت النبوة وصار رأس حمزة مطلوباً فقد جعل النسوة والصغار والأولاد والرجال تخرج من مكامنها في الظلام ومن أقبية الأزقة، وفتحات الخرائب وحفر الصاغة والحدادين من تصدعات الغرف إلى الخيمة التي فيها رأس الحسين، يتلو ما تيسر مِن الذكر الحكيم، وصار الرأس مزار للناقمين على يزيد وهكذا في دمشق اندلع اللهب من شرارة الجندي حمزة ورأس الحسين يحاوره من كربلاء حتى دخول دمشق، وبالمحاورة تحول المهرج إلى حسيني الهوى ما كان من كلام ٍ بينه والحسين، جعله الآن كلاما من الحسين إلى القوم جميعا (أيها الرجال والنساء جئت إليكم برأسي فقط، وتركت ُ جسدي هناك، يضيء مكانا معذبا آخر.. جئت لنزع الحديد الذي يدمي أقدامكم ونفوسكم 145).
✤
رواية (رأس الحسين) يحق لي تصنفيها (مسراوية) أي مسرحية روائية. فالحوار يشكل نسبة عالية وما يتبقى فهو للسرد. والرواية مكثفة مشوّقة والسيء فيها حروفها الطباعية الناعمة.
July 15, 2024
الراوي وعلمُ الاجتماعِ الوطني
كتب : عبـــــــدالله خلـــــــيفة
تجسد القصةُ أطواراً من التحول الاجتماعي، ولهذا تغدو لها مسارات مختلفة وإنجازات متباينة عبر العصور، وفي البحرين خلال القرن العشرين تنامت هذه القصة متأثرةً بالواقع وتحولاته، وبالتأثيرات الإبداعية العربية والعالمية.
بتشكلِ الفئات الوسطى والعمالية مجسدتين الحياة الحديثة، راح الفرد يعي ذاته المستقلة وسط بناء قبلي قروي تقليدي، تحضنه هذه المؤسسات وتخضعه لسيطرتها وأشكال وجودها، لهذا يصعبُ عليه الانسلاخَ منها إلا عبر نمو الفئات الحديثة، وعبر صناعته لأدوات وعيه المختلفة ومنها أجناس القصة والرواية والمقالة والدراسة والفنون وغيرها.
حين تظهر القصة فهي تظهر في عالم ضبابي فهي ليست قصة ولا رواية، بل شكلٌ هلامي منهما، وهذا يعتمد على طبيعة المُنتج وموقفه الفكري السياسي، فكيف هو موقعه الاجتماعي وما هي أهدافه؟
وهو يعبرُ عن هذا من خلال صنع الشخصيات والأحداث والأجواء ويتوقف تطوره على مدى خلق صلات متنامية مع الواقع، ولهذا فإن صنع الشخصية الإنسانية الفنية هو بؤرة مركزية لهذا كله، فهذا الشخصيات تعبر عن ذاته.
وفي القصة البحرينية في ذلك السديم الأولي فإن الضبابية تغلف كل شيء، فالفئات المتوسطة الصغيرة المنتجة للأدب والفنون مقسمة محدودة، ذات أشكال وعي مضطربة، لم تُظهر مفكرين وباحثين قادرين على تعبيد الطرقَ لها.
ويغدو التعبير القصصي شكلاً أولياً لتفكيرها، وقد قام الكتاب البحرينيون بتجسيد الشخصيات دون أن تكون معبرةً عن ذواتهم، فهم بلا رؤى فكرية واضحة عميقة، ومن هنا فإن(البطل) موجود ولكنه بلا بطولة، فهو كيان هلامي مهزوز يتحطم في خاتمة المطاف.
المؤلفُ سواء كان كاتباً سارداً أو كاتباً راوياً لا يذكر إنه هو هذا السارد أو الراوي، فهو لا علاقة له مباشرة بالبطل، فهو غريب عنه! وهذا الموقف هو نتاج سمعة القصة في ذلك الحين، التي ترويها النساءُ كحزاوٍ، وبيئة العائلة الممتدة لا تُعنى بالفرد وإستقلاله، وتسود فيها قصصٌ حتى التراثية منها وهي بلا كيانات فردية مستقلة.
ولهذا فإن المؤلف العصري في ذلك الوقت يلغي روابطه بالبطل المنبوذ المعروض والذي يشاركه المؤلفُ آلامه من وراء الستار!
إن كلاً من أحمد كمال وعلي سيار وموزة الزائد من البحرين وفهد الدويري وحمد الرجيب من الكويت سيجد نفسه في النتاج وليس في الشخصية المتصاعدة عبر القصص، فهو لا يشكل ذاته الإبداعية عبر شخوص مجسدة له بل عبر شخوص غريبة عنه.
لهذا سيكون المؤلفُ سارداً، يشكل سرداً عارضاً لأحداث وشخوص، وليس راوياً مذكوراً داخل السرد. فالشخصيات غريبة عنه يعرض مآسيها فقط.
(في قصة»جناية أب لأحمد سلمان كمال نجد الشخصية المحورية وهو الابن يرى أمه واخته الصغيرة تنتقلان إلى بيت من بيوت السعف.. بعد أن طلق أبوه أمه)، من كتاب (الراوي في عالم محمد عبدالملك القصصي)، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ص 15.
وهذا الطلاق يكون سبب دمار الابن وتحوله لمتشرد ومريض ثم للص. يقوم المؤلفُ بإرجاع مآسي أبطاله لتفكك العائلة وخرابها الداخلي الناتج عن أشكال الزواج السائدة.
تعرض أغلب قصص المرحلة هذه الظاهرة، وبطبيعة الحال لن يعرض المؤلفُ ذاته أو شكلاً لتجليها في مثل هذه المواد.
عدم ظهور المؤلف كبطل تعبيري هو بسبب فقدان البطولة فالشخصيات ممسوحة إجتماعياً، ولهذا نجد المؤلفين لا يشكلون سيراً قصصية لهم، وبالتالي لا يستطيعون التعبير عن فئاتهم الاجتماعية، فميل هذا الوعي غير موجود، فلا نجد سيرة لأحمد كمال يعرض فيها تجربته، ولا نجده يصور شخصية مثل محمود المردي ويكتب سيرته أو يقوم المردي نفسُهُ بتصوير تجربته السياسية والإعلامية.
إن عرض تجارب الظهور الأدبي الفكري السياسي شبه معدومة، رغم إن البطولة موجودة متقطعة، بين ظهور أدبي إلى تجل سياسي وصراع مع الاستعمار والتخلف.
إن الفئات الاجتماعية السائدة حينئذ لا تشكل ذواتها الطبقية المميزة، وتتذبذب مواقفها ولا تصعد وجوداً سياسياً مميزاً.
لماذا يتبدل وضع الراوي في القصة القصيرة البحرينية ليصبح قريباً من السارد المؤلف لدى محمد الماجد ومحمد عبدالملك؟
في حين أنه لدى أحمد كمال وعلي سيار ليس كذلك، فهو ناءً عنهما فلا يوجد سوى صوتُ المؤلف السارد الكاتب؟
كما قلنا كان حضور المؤلف في قصص الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين يبدو مشيناً، فالقصة تبدو عملاً أدبياً متدنياً، وفي أجوائها (المنحطة) تلك كان ظهور المؤلف أشبه بالعيب!
الحال انقلب لدى الماجد وعبدالملك، صار حضور الماجد في قصصه واسعاً وكذلك تنامى هذا الحضور لدى محمد عبدالملك، ونعزو ذلك لتبدل مكانة القصة وصيرورتها جزءًا حيوياً من الإبداع والمجتمع، وكذلك فإن المؤلفَين صارا على علاقة وثيقة بالصحافة التي كانت تعتمد على الخبر والتحقيق (الريبورتاج) وتصوير الناس.
قصة الخمسينيات الخيالية التقريرية كانت تُزاح لصالح قصة قريبة من الحياة، والحياة كانت في الشارع الملموس، وإذا استقى الماجد قصصه من حياته الشخصية التحولية بدءًا من الرفاع إلى المحرق والمنامة راسماً تجاربه فيها، مسقطاً ذاته وأحزانه عليها، فإن محمد عبدالملك راح يصور يقظة الحارة وشخوصها وصراعها وصعودها لكن من خلال ذاته المراقبة المسجلة لما يدور.
بطبيعة الحال كان الراوي ثيمة فنية ضرورية، وتداخلت شخصية الكاتب السارد بالراوي الموجود في جسم القصة كجزء منها كما يفعل الماجد وكمراقب خارج عنها كما يفعل عبدالملك ثم يدخل فيها في قصصٍ تالية وكجزء عضوي فيها، وهو أمر عنى تطورات إبداعية كبيرة ومشكلات إبداعية كذلك.
هذه الجوانب الرفيعة في تطور القصة القصيرة لم تكن مُراقبة مدروسة في عمليات النقد البحرينية لأسباب تتعلق بمنهجية المؤلفين، فالباحث إبراهيم غلوم في كتابه (تطور القصة القصيرة بين الكويت والبحرين) يركز على الأسباب الاجتماعية التاريخية التي تكونت القصة فيها في كل من البلدين، ثم حين يجيء لتكون القصة القصيرة في البحرين ينقطع عن تلك المقدمات الطويلة ويكتب قراءاته الخاصة عن التجارب، لهذا لا تحوز مسألة مثل الراوي مكانة خاصة.
فيما تجيء الكاتبة (أنيسة السعدون) في كتابها عن الراوي في قصة عبدالملك لتأخذ قصص محمد عبدالملك كإنتاجٍ مطلقٍ خارج التاريخ الاجتماعي الفكري، مركزةً على إسقاط شهادات نقدية عربية وعالمية على جوانب بنائية فنية مهمة من هذه القصص.
مسألة الروي وظهورها وكون محمد عبدالملك جزءًا من حارة يعيشها بكل جوارحه، وهي حارة في غليان اجتماعي سياسي، وثم تجيء مسألة ذوبان تلك الحارة وغياب شخوصها الحية، وبقاء المؤلف فيها وقريباً منها وتسكنه تحولاتها السابقة وتزعجه تحولاتها الراهنة، أمرٌ مهم ومؤثر كبير، وتقوم هاتان اللحظتان على تطورين اجتماعيين سياسيين بحرينيين كبيرين غير مدروسين لدى الباحثين، وهما التطوران اللذان يتركان بصماتهما على البنية الفنية.
تقوم ضرورة بحث الجوانب الفنية المرهفة هذه على تتبع التطور الاجتماعي والفكري للبحرين خلال عقود الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن العشرين لكشف التحول الفكري الروحي العام ومشكلات التطور السياسي، فتصويرية المؤلف وبقاؤه ضمن المادة الإبداعية يجعل جزءًا من عمله تسجيلياً لا يكشف قوانين تطور البنية الاجتماعية، التي ينبغي أن يدرسها ويحللها ويكشف عللها، لا أن يلتصق بجزئيات كثيرة فيها، ويبقى فيها.
إن الماجد يبقى في تلك الجزئيات وتصير هي آلامه حتى يذرو نفسه، في حين يبقى محمد عبدالملك معها ويحللها ويربطها بحالات فكرية مركبة شخصية وعامة.
إن بقاء أحمد كمال في منهجية قصصية متجمدة يؤثر على توقف هذه القصة، في حين قام علي سيار بتحول مع انغماره في المجتمع الكويتي وبدّل من تقنيته بعض الشيء، وبقي محمد الماجد في تقنيته الفردانية المغلقة وبدّل محمد عبدالملك من هذه التقنية الراوية.
هذه كله جعل تقنية الروي تعبيراً عن علاقات إبداعية وفكرية وسياسية غائرة موضحة العديد منها في النقد الجديد بالبحرين.



