عبـــــــدالله خلــــــــيفة's Blog: https://isaalbuflasablog.wordpress.com , page 16
July 10, 2024
عبدالله خليفة: المغامرات اللغوية أبعدت القارئ عن الرواية
عبد الله خليفة كاتب بحريني صاحب عدد من المجموعات القصصية المتميزة التي بدأ نشرها منذ منتصف السبعينات بمجموعة لحن الشتاء ثم توالت مجموعاته الرمل والياسمين ويوم قائظ ودهشة الساحر وجنون النخيل.
ودخل خليفة حقل الرواية بصدور روايته اللآلئ في بداية الثمانينات ثم توالت رواياته: القرصان والمدينة والضباب ورأس الحسين وعمر بن الخطاب شهيدًا والتماثيل كما كتب العديد من الدراسات النقدية والفكرية. وبمناسبة صدور عمله الجديد التماثيل كان هذا الحوار معه:
✾ صدرت لك حديثا رواية التماثيل ماذا عن الخطوط العريضة لهذه الرواية؟
❀ التماثيل رواية من روايات الحياة الاجتماعية المعاصرة وليست تاريخية، وهي تتناول الفترة الحالية في البحرين وتدور حول شخصيتين متناقضتين، الأولى بسيطة ومتفتحة وخيرة ولكنها ساذجة، والثانية شخصية ذكية وشريرة، وتصطدمان مع بعضهما بعضا حيث يقوم الرجل الشرير باستغلال الرجل الطيب في أعمال يتورط على أثرها في العديد من التجارب إلى أن دخل السجن وهناك تعلم الساذج كيفية التعامل مع الأشرار، بعد لقائه بأحد المناضلين الريفيين الذي يقوم بحراسة كنوز التراث التي هي التماثيل.
✾ شخصيات الرواية حلمية أم واقعية؟
❀ هناك صبغة تجمع بين الحدث اليومي الحقيقي من خلال شخصيتي حارس التماثيل، والساذج الشرير وهي ترميزات لأنماط بشرية وقوى متصارعة في الفكر والموقف والفن الآن بعدما كتبت مجموعة كبيرة من القصص والروايات لم أعد أكتب ما هو تسجيلي فوتوغرافي، لكنه يستفيد من المادة الحياتية ويتغلغل فيها ويضعها في صيغ ترميزية.
✾ ما سر تحولك من الكتابة التاريخية إلى الكتابة الواقعية؟
❀ كنت دائما مهتما بجذور الحالات القصصية والروائية كجذور بلدي والحالات الشخصية والفنية وصيرورة الشخصيات كما في روايات اللآلئ، وهي عملية مهمة لكشف تطور الشخصيات وإبراز تناقضاتها وجذورها الروحية، هذا المنهج دفعني إلى دراسة التاريخ الإسلامي بعد تخرجي من قسم اللغة العربية في معهد المعلمين، واصلت الكتابة الأدبية بهدف البحث في جذور الإسلام والأمة العربية، وأصدرت كتابا من أربعة أجزاء حول تطور الوعي العربي الفكر الفلسفي.
✾ هل تربط الرواية بالتاريخ لتعيد التعبير عما قاله التاريخ بلغة أخرى أم التعبير عما لا يقوله التاريخ؟
❀ لم أكتب الرواية بشكل تسجيلي تاريخي وتوثيقي دراسي وإنما بشكل روائي، أستخدم أسلوبا شعريا ولغة مرنة بحيث لم أتوقف عند التيمات التاريخية والتقارير المتيبسة للسرد القديم، حيث تتداخل الضمائر وينمو السرد عائدا للماضي ومتوجها للحاضر وتتشكل شبكة من الشخصيات مثل عمر في رواية رأس الحسين في المدينة وهو يجابه الاستغلاليين ويساعد الفقراء.
✾ ما حجم ودور الخيال في هذه الروايات التاريخية؟
❀ حجم الخيال يبقى محدودا لأنه توجد لديك مادة لا يجوز تحريفها أو تشويهها ودور الكاتب هو إضفاء عوامل التشويق على هذه المشاهد مثل الصراعات الحربية.
✾ كيف تتقاطع كمثقف مع المفاهيم التجديدية للغة؟
❀ الأسلوب الحديث بمغامراته اللغوية وسرده المنقطع واستخدام المونولوجات أو المشاهد المسرحية أو تعددية الأصوات هذا كله مطلوب لكن ينبغي أن يؤخذ بحذر وتوظيف حقيقي، لأن هناك هوة كبيرة بين الكاتب والقارئ، هذه الهوة تشكلت بسبب المغامرة المتطرفة في اللغة، حيث أصبح الكتاب الأدبي منبوذا وغير مقروء، ونحن نحاول أن نجمع بين تطوير اللغة واكتشاف مستويات غنية فيها وفي نفس الوقت نسعى لخلق لغة اتصال مع الجمهور.
✾ ما الهموم التي تشغل الكاتب البحريني؟
❀ هي نفس الهموم في الأقطار العربية الأخرى لا تختلف مثل قضايا الحرية والتنمية والفقر والغنى التي أشتغل عليها منذ أربعين عاما، واشتغل عليها قبلنا كتاب كبار، ولكن مهمتي في الرواية أو القصة تحويل هذه القضايا الكبرى إلى تيمات قصصية.
✾ برأيك متى ينتهي الروائي كروائي؟
❀ عندما يستنفد تجربته ولا يستطيع أن يستكشف عالمه ويقدم تحليلات إبداعية مهمة فيه وعندما يكرر نفسه ويعيش على ذات الموضوعات والأساليب.
✾ أين موقع المرأة في كتاباتك؟
❀ المرأة دائما ملازمة لي في كتاباتي خاصة في الرواية، نجد العديد من الأشكال كانوا نساء مثل بطلة روايتي امرأة التي تقود عملية التغيير في القرية، وتكتشف خيانة زوجها السياسية.
✾ أين أنت من المشهد الثقافي البحريني؟
❀ كنت في قلب المشهد طيلة أربعين عاما وكتبت مختلف الأنواع الأدبية والدراسات النقدية والفكرية وأخوض المعارك الفكرية من أجل تجذير هذا الأدب ودفعه نحو آفاق أخرى جديدة.
July 2, 2024
علي الشرقاوي : قصائد الربيع ــ الموجه للأطفال
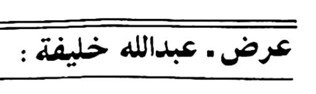
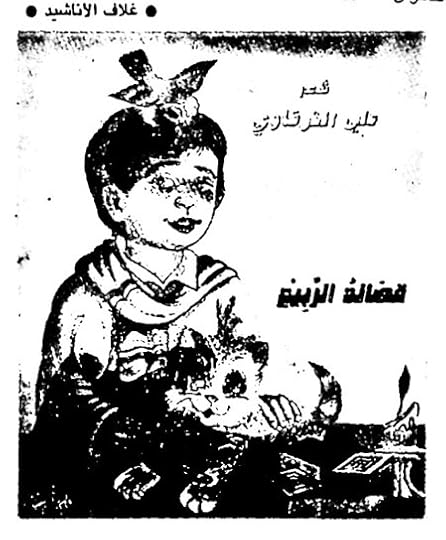
إلى أين يريد الشاعر علي الشرقاوي الذهاب بكتاباته للأطفال؟ ماذا يبغي ان يصنع في هذا النوع الادبي الصعب المتفرد؟ هل يقدم شيئا عميقا وبسيطا. وآسرا للصغار أم ينسج محفوظات تقليدية طالما صيغت من قبل بعض تجار «التربية»؟!
هل هو يتغلغل في كلماته الشعرية المختلفة هذه كما يتغلغل في قصائده. لا يفصل بين روحه هنا وهناك، فيعتبرها وسيلة جديدة للتأثير والخلق، بعد ان «تمكن» من التعبير للكبار، فيلون اسلوبه وافكاره ذاتها من أجل الصغار؟
في كتاباته الشعرية للكبار هو باحث عن مناطق جديدة للتعبير ، ومساحات مختلفة للكشف ، وقادر على الاكتشاف والاحساس العميق بالتحولات في البيئة والانسان ، فهل يتعامل مع الصغار ، بهذا الثراء الروحي ، أم يأتي اليهم كشخصية أخرى ، لا تمتلك ذلك الثراء؟!
علينا ان نقرأ، ولنطالع القصيدة الأول من ديوانه الجديد ، الموجه للأطفال ، والمسمى «قصائد الربيع» ، الطبعة الأولى ، الناشر غير معروف :
(أغنية الصباح)
غردي
غردي يا طيور
زغردي للصباح
والندى والزهور
غردي
فالفضا ملعب
والغصون سكن
شرقي
غربي في الرياح
واحملي في الجناح
بسمة
لعيون الوطن. ص 8
يتعامل الشاعر هنا مع القصيدة بعقلية تقليدية مدرسية , وليس بثراء شعرة وخبرته الفنية .فإنظر كيف انطلقت الأفعال الأولى :
غردي ، زغردي ، غردي .. فهذه الأفعال يقولها اطفال الشرقاوي في القصيدة ، وهم يستقبلون الطيور . وهم يستقبلون الصباح .
الاطفال هنا يقفون في طابور مدرسي ، متطلعين إلى هذه الطيور وكأنها مفتاح للصباح . فالصباح لا يتشكل إلا من خلال الطيور ، التي تنطلق وتزغرد فيتشكل بدء النهار .. النهار إذن مرتبط بالطيور وزغردتها ، وليس على سبيل المثال ، بنضوج الخبز في التنور ، أو نزول العامل الى باصه المنتظر في ضباب الصباح ، أو نهوض الأم مبكرة من الفراش ، لا ، فالصباح في أغنية الشرقاوي مرتبط بنهوض الطيور وزغردتها , ولكن هذه الكائنات ليست مفصولة عن الانسان ونهوضه ، وعن اندفاع الأم لصنع الخبز , أو شرائها للحليب ، أو نهوض الصغار لبدء الدراسة . فإنها كل متكامل , ولعل الأم لدينا الآن لا تسمع العصافير وهي تعد فطور الصباح ، ولعل الطبيعة بتغاريدها ونباتها ، انقطعت عن بصر بعض الأطفال وهم ينهضون مبكرين, لكن هذه الكائنات , الانسان والطيور والطبيعة , تنتعش وترفرف وقت الفجر ، وتستعد جميعا للانطلاق والحياة والنشاط ..
ولكن على عكس هذه الجدلية الحقيقية . فإن القصيدة , وفي محاولتها للتغنى عبر وعي الصغار وتقليد رؤاهم ، عجزت عن اكتشاف تنوع الظاهرات الحياتية الطبيعية ؛ ففصلت الطيور عن الطفل ، وفصلت الكون عن البشر ، وفصلت الطيور عن الصباح ، فيغدو الفجر زغردة للطيور فحسب ، لا زغردة للانسان كذلك ، لذا فإن الصياغة تعود بوعي الطفل ، لا إلى وعيه الحقيقي , بل الى الرؤى القديمة , الفاصلة بين الانسان والطبيعة ، أي انها لم تصل الى الرؤية الجديدة , التي تضفر بين الطبيعة والحياة اليومية؛ وهي رؤية الطفل الحقيقية، هي رؤية الشرقاوي في شعره المخصص للكبار.
وهكذا تجد فعلى: «غرديه»، «زغردي»المنطلقين من فهم «الطفل» يصيغان علاقة منقطعة بين الانسان والطيور . فالطفل واقف ، جامد ، يقول للطيور «زغردي !» ولكنه غير قادر على الزغردة . والطفل الحقيقي لا يفصل نفسه عن الطيور والشمس، بل ان وعيه يضعه بينها بكل بساطة . فهو يزغرد معها ، ويطير ، ويسافر، ويقاتل, اذن هنا نجد الوعي التقليدي مسيطراً قابضاً على الكون , مانعاً اياه من التمازج مع الصغار. بمعنى أخر ان الساكن في ذات الشرقاوى جمد المتحرك في ذات الطفل . فظهرت الأوامر «زغردي !».
وظهر الفصل الذى لا يحسه الطفل ؛ فتحول الشاعر الى مدرس تقليدي ، لا إلى رجل يتفهم الطفولة ، يتحسس دفقة الكون الصباحية فيزغرد ويرتعش كالعصفور ويغني كطفل متفهما مشاعره وحالاته، محاولا خلق صباح حقيقي له مدركاً ارتعاشاته وأماله فيعي ان للطفل روحاً تريد النهوض والاندفاع وانها لا تقل جمالا عن الطيور وزغردتها، بل ما هذه الطيور والزغردات والشمس ودخان الفطور واستيقاظ المدينة سوى صدى لروح هذا الطفل المشوشة العارمة التي سوف تحلق وتطير بأجنحتها المتعددة إلى السماء والسطوح والشمس والعمل !
هنا عبر كسر الرؤية التقليدية فحسب، يمكن للغة ان تتحرك، وأن تتخلص من سيطرة الأوامر، والانفصالات الشاسعة بين الطفل – الطبيعة ، والطفل - الحياة والموقف . أي ان تتوحد لغة القائل, الطفل, بلغة الشاعر, فتندفع وتكسر هذا التردد والنمطية اللغوية الباردة .
وانت ترى الشاعر يواصل تعداد الأماكن التي يحق للطيور ان تزغرد لها : الصباح – الندى – الزهور .
لا للسطح، أو اصابع الأم, أو حقيبة الطفل, أو باص المدرسة، أو نوافذ الفصل المشرقة، فتلك المناطق التى اختارها لزغردة الطيور هي اماكن طبيعية بحتة ، أي اعاد انتاج الفصل بين الانسان والطبيعة مرة اخرى ، أي اعاد تكرار الرؤية التقليدية، عبر توسيع نطاقها ..
فالطيور التى يتخيلها الشاعر، ليست هي الطيور التى يتخيلها الطفل، فهي طيور جامدة، مناخها الطبيعة البعيدة، لا الحياة اليومية، لا حياة الطفل, وسريره ، ومدرسته, وأرضه، ونخيله, انها طبيعة خاصة مقولبة بخيال جمّد الأشياء، لا طبيعة طفل متحركة فعالة خلاقة، لا تفصل بين البشر والأشياء والحالات.
وهذا التجميد لانطلاقة الطيور، الذى تصوره الشاعر ، جزء من الرؤية ، التى جعلت من الانطلاق والحرية ، صفة للطيور، لا للبشر ، وبالتالي ، جعلت مناطق الانطلاق والحرية ، هي مساحات الطبيعة المنفصلة عن الانسان .
فالحرية والحياة والتغيير ستكون في الطبيعة المفصولة عن الطفل ، ستكون في الندى والزهور ، ولن تظهر في الفصل الدراسي، والبيت، أو غيرها من المظاهر الحياتية، وهنا يقوم الوعي التقليدي، بتجميد الانطلاق لدى الطفل ، عبر تقليص مساحات الحرية في حياته اليومية .
فبعد ان اعطى الطيور الحرية والسعادة والانطلاق، حبسها عن التأثير في الطفل، فتجمد الطفل في صباحه، واندفعت الطيورخارجاً عنه. فهو يغني لحريتها هي، لكن لا يغني لاندفاعه وحريته هو .
والشاعر في النشيد، يواصل توسيع حرية الطير، عبر كل الجهات، وعبراجواز الفضاء، لكن دون ان تمس شيئاً حقيقياً، أو تكسر قيدا محدداً. انه يأمرها : «شرقي !», «غربي !». ولكنها تطير في فضاء عدمي, فارغ, لا تضاريس فيه, ولا ملامح نفسية له . ومن هنا فالقصيدة تنمو وهي تأكل نفسها وتدمر ذاتها , ولا تجد شيئاً تمسكه إلا العبارات المحفوظة : واحملي في الجناح / بسمة / لعيون الوطن .
كيف؟ فالجناح لم يمسك شيئا ولم يحمل شيئا , لأنه لم يغتن بجدل خصب مع الطبيعة والانسان . وبالتالي فان الوطن , جامع تلك الوحدة الخصية بين الانسان والطبيعة, بين الحياة ومشكلاتها , يتبخر حالما يظهر .
ويواصل الشرقاوي ذات الهندسة التقليدية في أناشيد اخرى , فلنقرا نشيد «الفصول». ص 11 :
اذا اتى الصيف لنا
تبتسم النجوم
ويضحك القمر
اذا اتى شتاؤنا
تنتشر الغيوم
وينزل المطر
اذا أتى الخريف
تجدد الأشجار
أوراقها
لتنتج الثمر
لكنه الربيع
اذا أتى
يجدد الحياة للبشر .
مرة اخرى يغدو الفصل بين الطبيعة والانسان، في قصيدة موضوعها التشابك المفترض بين الطبيعة والانسان، وفي وعي «ذلك» الانسان الذى لا يعرف الفصل بين الطبيعة والانسان ، يغدو هذا الفصل شيئًا قوياً ، وكأن الشاعر غير قادر على الانفكاك منه ، وبالتالي فهم الطفل والابداع له .
فالصيف عندما يأتي «تبتسم النجوم»، و«يضحك القمر - وكأن شتاءنا يخلو من النجوم والقمر – ولكن دعك من هذا وانظر الى علامة تحديد الصيف ؛ عبر مظاهر الطبيعة وحدها، عبر مظاهر خارجة عن الانسان، فالصيف علاماته ابتسامة النجوم وضحك القمر, لكن لا علاقة له بالشمس المتوهجة والعرق والبحث المضني عن نسمات شحيحة، أي ان سمات الصيف موجودة في اشياء خارج الانسان ، بل ان الأنسان هنا لا يغدو مهما ، فيكفي ان النجوم تضحك؛ لكن هل هناك علاقة بين امتلاء السماء بالنجوم والعاب الأطفال في الليل، لا، لا توجد علاقة ، فالشاعر انفصل عن الطفل, وقولب السنة قولبة ألية, لا علاقة لها بمشاعر البشر، وهو يسعى لتحفيظ الطفل اسماء الفصول وتواليها، لا ليشعره بها، وبالطبيعة واحوالها وتحولاتها، وبمجتمعه وحياته المتأثرين، على نحو خاص، بهذه الفصول؛ انه يريد منه ان «يحفظه»، هذه الأسماء، لكن لا يهمه علاقة هذه الفصول بالطفل، أو الأشكال الملموسة لتجلي الفصول لدى طفلنا؛ فكأنه يكتب لطفل مجرد عليه ان يحفظ اسماء الفصول ويتلقنها، وهنا لا توجد فصولنا، أو مناخنا الخاص، أو حياتنا, أو انساننا، بل توجد صورة مقولبة عن الفصول ينبغي للطفل ان يحفظها، عبر الترديد الآلي لهذه المحفوظة .
ثم لاحظ هذا البناء التقليدي النمطي, عبر ادوات الربط النثرية التقليدية «اذا اتي ..»، لتتالى الأفعال المرتبطة بالمجيء «تبتسم ..»، ثم تأتي ادوات العطف والشرط لتجمع مسبحة طوية من الفعال :
«اذا اتى..»، «تنتشر..»، و«ينزل..»، «اذا اتى..»، «تجدد..» و«لتنتج..» الخ..
عملية آلية عبر تفعيلة متكررة ، كالقضيدة السابقة ، يسودها المنطق النثري الفصلي التعليمي .
ويستمر المنطق الداخلي الفاصل بين الطبيعة والانسان فتغدو الأبيات نسخا له، أي تكراراً للسكون واللاجدلية وعدم التماسك الفكرى . فهو يختمها بمثل كبير على هذا الفصل عندما يقول «لكنه الربيع/ اذا اتى / يجدد الحياة للبشر» .
فكأن بقية الفصول لا تقوم بالتجديد, وكأن ضحك القمر, وانتشار الغيوم ونزول المطر وقدوم الخريف, كلها, لا تحمل تجديدا للبشر, فقط «الربيع» الذي يوم بذلك.. هنا نجد ان الآلية في الصياغة تدفع الشاعر لوضع «لكن» التي دمرت حتى منطقية البناء ذاته .
فكافة الفصول خلافا للخبرة المعاصرة - لا علاقة لها يتجديد حياة البشر، بل لها علاقة بتجديد حياة النبات؛ ووحده الربيع الذي يجدد حياة البشر! ويتحول الفصل بين الطبيعة والانسان هنا، الى اخطاء معرفية وليست منهجية فحسب .
هكذا لا يقوم الشرقاوي ببناء نشيد غير تقليدي للطفل، فيضفي من روحه وخبرته الفنية الطويلة, لمسات عميقة على القصيدة الموجهة للطفل؛ فيشكل نشيدا معاصرا مفعما بثراء فكري وبساطة تعبيرية ، بل هو يتخلى عن عصريته ويتحول الى تقليدي يكرر القاموس السابق .
June 30, 2024
حول رواية اللالئ لعبدالله خليفة الابطال بعيدون والمكان قريب
كتب : حسن داوود
المصدر السفير
التاريخ 1983 – 3 – 19
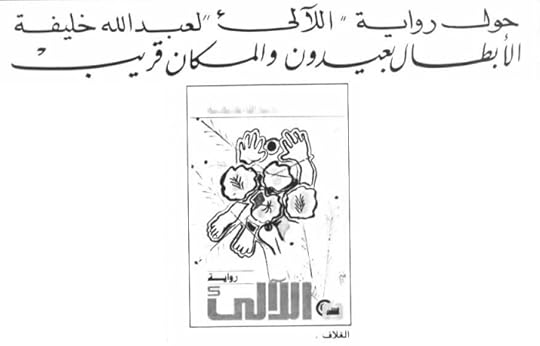
قارئ رواية «اللآلئ» لعبدالله خليفة لا يستطيع أن ينتزع الابطال من المحيط المكاني الذي يحتويهم . دائما يرى القارىء أبطال الرواية عن بعد من مسافة تفصله عنهم . فحين هم في البحر يراهم القارىء من عل. أولا يرى السفينة الهرمة، ثم يراهم على متنها نقاطا صغيرة. وحين تهب العاصفة العاتية وتحطم السفينة وترميهم في الصحراء، نراهم ضائعين في مساحات من الرمال لا تنتهي ايضا في الصحراء هم بقع صغيرة ، ويراهم القارىء من عل. وحين يتحركون أو يتكلمون أو يجري بينهم حدث فكأنما الكاميرا السينمائية هبطت من علو شاهق واقتربت من رجلين يتحاوران لكن تقف الكاميرا في مكان تحرص منه أن تظهر الرمال المترامية في خلفية الصورة .
هنا تختلف الصحراء عن تلك التي قدمها غسان كنفاني في روايته «ما تبقى لكم» (التي تأثر في كتابتها برواية الصخب والعنف لفوكنر). في غسان كنفاني الصحراء مكان لا يلبث أن يتحول إلى بقعة رمل صغيرة حين يتواجه البطل ونده الاسرائيلي. وفي لحظات الترقب الحاسم بينهما يبدو وجه الفلسطيني مستديراً وكبيراً. وجهان يتربصان أو يتحاوران لكنهما يطغيان على المكان ويلغيانه.
في رواية عبدالله خليفة لا تتسع الوجوه لتشمل محيط الكتابة كله.
تبقى دائماً اشياء في المكان ، صغيرة ، وكل ما تفعله يدل على سطوة الصحراء وطباعها حين يتنازع الابطال الهاربون، حين يقتتلون ويتحاسدون وتبلغ بينهم غرائز التملك ذروتها ، فإنما يكون ذلك دليلا على التأثير الذي تحدثه الشمس اللاهبة وفقدان الماء في الشجر.
ابطال الرواية، حين يتحركون. فكأنهم يخرجون من الصحراء طبائعها المختبئة ، يعطون للمكان بعده البشري . هم كائنات صحراوية لذلك لا تنفصل اقدامهم عن الرمل ووجوههم عن الشمس ، ولا يتنازعون إلا كمجموعة مشبعة الغرائز. مجموعة ليس في الإطار المكاني المترامي ما يدل على أثر مما أثار الاتفاق أو التآلف.
كل مشهد ترسمه الرواية كبير ومتسع البحر . الصحراء ، والأبطال لا يتعثرون بل يموتون، لا ينمو بينهم الحوار بل يشج واحدهم رأس آخر فيتدفق الدم احمر غزيراً ويبطل أي فاعلية لاحتمل كلام افعل البشر الضائعون في الصحراء متلائمة مع الاتساع الخرافي للبحر والصحراء من حولهم ولا يتم التعبير عن هذا التلاؤم بالقتل وحده ، بل بإزالة كل أشكال العلاقة الموروثة بين الرجال الضائعين .
في قلب الصحراء وفي مرحلة شديدة من عطش الرجال وضياعهم لا يعود أمر «النوخذا» ( وهو قائد سفينة صيد اللؤلؤ وصاحبها) مطاعاً، لا تعود رغباته مستجابة ، ولا تحفظ مكانته الاصلية، المستمدة اصلاً من اليابسة وليس من البحر . في قلب الصحراء والضياع، يتعرى «النوخذا» من صفاته ومرتبته ويصبح جسدا صرفا ، رجلا مثل الآخرين، ينساق معهم كواحد بينهم . في آخر الرواية، ولا يعود شيئا مختلفا عنهم .
حين يكتب عبدالله خليفة عن المكان الشاسع والقاسي، عن البحر والصحراء، عن أمكنة لم يغيرها التاريخ بل بقيت هي نفسها على مداره .
حين يكتب عبدالله خليفة عن ذلك كله فإنما يكون ينقل هذه الامكنة الى مجال الكتابة ويجعلها أدبية شرط ذلك، شرط أن يصف الكاتب سفينة عتيق خربة فيها طبائع البشر ، أن يعيش الكاتب حنيناً الى سفينة لم تعد موجودة شرط أن يحضر المكان سيدا طاغيا ، هو ان يبتعد البشر الصيادون والضائعون عن البحر والصحراء. عبدالله خليفة يتذكر زمناً وأمكنة.
بنتابه حنين إلى ما لم يعد موجوداً. إلى بشر باتوا وكأنهم من ماض سحيق بينما بعضهم ما زال حياً ويستطيع ان بسرد بالتفاصيل حكاية يعتبرها الجيل الذي أتى بعده ذكرى شديدة البعد.
يستطيع صيد اللؤلؤ في البحرين الكهل الذي ما زال حيا ، أن يتذكر وجوه الصيادين والخشب الواقعي الذي صنعت منه صارية السفينة .
ويستطيع ايضاً أن يستعيد حشرة صغيرة كانت قد ملأت عينيه وهو يحدق فيها في الصحراء المترامية . الراوي عبدالله خليفة لا يفعل ذلك. بل ينقل اشياء تلك الحياة وملامحها الى حيز الأدب . وفي الأدب ، لا يعود يظهر من المكان إلا خاصية طاغية ، ومن حركة البشر إلا ما ينبىء بالمصير. نوع خاص من الادب، او نوع خاص من الرواية تجعل المجرى الذي تنتظم فيه الأشياء والأحداث وكأنه يسير بقوة التذكر.
التذكر الذي هو خالق الأنساق لأنه يوحد بين أشياء متآلفة ، معتمداً في ذلك على الزمن الواحد الذي يخترقها معاً.
عبدالله خليفة شاعر وروائي . يظهر هذا من لغة الرواية أيضاً. حيث لا وجود للكلام السردي الذي يحاول أن يكون صورة عاكسة للحدث لا يسعى إلى أن يغير في نبرة اللغة ودلالاتها تبعاً لتدرج موضوعه بين الوطن والحوار والحدث . اللغة هي واحدة . وحين تنقل قتالا بين رجلين تاخذ الارتخاء نفسه الذي تأخذه حين يصف الراوي الجبل العالي البعيد .
اللغة كانها تحوم فوق ما يجري ولا تهبط إليه. قارئ الرواية سيبذل جهداً ، أو سيقرأ المقطع مرة ثانية حين يتبين في نهايته أنه يدور حول حدث وليس حول وصف هنا لا تجهد اللغة .
لا تتوتر أو تنبسط أو تتسارع تبعاً لنوعية الموضوع واهميته بين المواضيع الأخرى لا تكشف اللغة عن فعل القتل كأنها تكشف عن سر أو عن كنز حدثي. حين يجد الرجال علي مقتولاً فإنما يقال هذا ببساطة وفي السياق الطبيعي كان فعل القتل حدث عابر أو حلقة من حلقات الكلام .
«بدأ رجل يجلدك ماذا بقي فيك ؟ تكلم ، تكلم ، ماذا أعطاك أولئك الأوباش ؟ اهانوك ، بصقوا في وجهك ، تركوك وتبعوا آخرين . تكلم لترجع إلى أهلك حتى بلا لؤلؤة واحدة اتكلم ! سيجدونها، الان يفتشون خالداً ، هو الذي سرقها وداسك فانتقم منه…».
هذا المقطع يبدو وكأنه فاصل من مناجاة ، سيناريو من حدث متخيل ، أو استعادة لحدث ماض بصيغة التذكر. هذا ما يعتقده القارئ . لكن ، في الرواية ، هذا المقطع هو ذروة التوتر في البناء الروائي، ويعبر عن اللحظة الأكثر خطراً وتعقداً في الرواية .
القارىء يحسب غالباً أن الراوي استعمل هذه الصيغة للخروج من الحدث الذي ينتمي الى المضارع. بينما في الرواية هذه تحضر الأزمنة الثلاثة في نسيج واحد . لا يأبه الكاتب لأن يوحد الاشياء في مجرى زمني واحد . ربما لأن الحدث ليس المهم بالنسبة له، بل مصدره والمحيط الذي يولده . وهنا أيضاً نعود الى الأبطال الذين لا يشاهدون إلا عن بعد ، من عل، كأنهم في الصحراء ، نقاط حين يتبعثرون ، وخيط دقيق على رمال الصحراء المترامية ، حين يسيرون إلى الهدف الذي لا يعرفون عنه شيئاً.
إسم الكاتب حسن داوود
المصدر السفير
التاريخ 1983 – 3 – 19
الأشخاص خليفة عبدألله
الموضوع القصة العربية
June 28, 2024
الموت في فينيسيا : توماس مان كتب : عبدالله خليفة
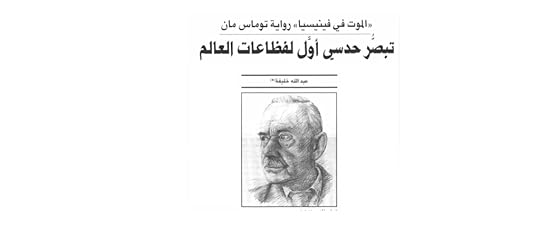
الأدب الأوروبي والأميركي الحديث هو الذي قاد تحول الوعي في العصور الأخيرة إلى اكتشاف عظمة الإنسان وصراعه مع القوى والمخلفات العتيقة التي تعيقه عن السيطرة الكاملة الحرة على وجوده وتألق روحه.
أسماء كثيرة بارزة في القرن السابق والحالي (العشرين) صنعت هذا الوعي عبر ممارساتها ومجاهداتها الخاصة العميقة، واكتشافها طرق سيطرة الإنسان على العلاقات الظالمة والشر والفساد. ومنها هذا الاسم البارز في أدب القرن العشرين: توماس مان، الذي نشرت له دار الهلال ترجمة رواية باسم (الموت في فينيسيا)، وهو الاسم الأوروبي للبندقية مدينة الجندول، والحقيقة أنها ليست رواية، بل أقصوصة تتكوّن من خمسة فصول. وتعبر الترجمة الجميلة التي قام بها بدر توفيق، عن هذه المعانقة بين الأدب العربي الحديث والأوروبي، حيث الأمانة الدقيقة والعمق والشاعرية في ترجمة الأصل.
كما تعبر من ناحية أخرى عن ضعف وجود توماس مان في أدبنا العربي، وغياب ترجمات أعماله الروائية الكبيرة، واكتفائنا بترجمة الأقاصيص التي سبق أن تُرجمت. فهناك ترجمة أخرى للموت في البندقية، ولكن لا توجد ترجمة «الجبل السحري»، «يوسف وإخوته»، و«المهرج» و«ماريود الساحر» و«الدكتور فوستوس» و«هنري الرابع» و«ال بودنبروك» وغيرها من الأعمال الروائية والقصصية والأبحاث التي كتبها توماس مان بين مولده سنة 1875. ووفاته سنة 1955، بعد حصوله على جائزة نوبل سنة 1929.
وتأتي أقصوصة «الموت في فينيسيا» في بواكير أعمال المؤلف، فقد ظهرت قبل الحرب العالمية الأولى، وفيها يبدأ بنقده الصغير لعالم الطبقة الأرستقراطية البروسية المتحكّم في مصير ألمانيا، هذا البلد العسكري، الذي وحّده بسمارك البروسي بجيشه الحديدي، والذي انطلق في حمى الصناعة والتجارة وغدا من أهم البلدان الأوروبية الرأسمالية من دون أن يمتلك مستعمرات كما هي الحال لدى منافسيه فرنسا وبريطانيا، ففجر حربين كونيتين راح ضحيتهما ملايين الناس.
الحياة في ألمانيا والوعي فيها من أخطر الموضوعات الثقافية الحديثة في العالم، وخاصة في مطالع القرن العشرين، حين ظهرت هذه الأقصوصة للمبدع الألماني الكبير.
ويبدو موضوع الأقصوصة مستهجناً ولا أخلاقياً الى حد كبير، فالبطل السابق ذكره، المؤلف المعروف، والرجل التقليدي، ابن الموظف الكبير، والذي كان أسلافه ضباطا وقضاة «رجالاً أنفقوا حياتهم في خدمة الملك والدولة»، والعقلية الوحيدة المختلفة بينهم جاءت من خلال أم البطل الكاتب وهي ابنة «قائد فرقة موسيقية بوهيمي النزعة»، هذا المؤلف يقع في افتتان مروع بفتى صغير جميل.
وفي هذا التأصيل فإن توماس مان يعطي الجوانب الطبقية و«العرقية» أهمية متساوية، فتبدو المكانة الطبقية الأرستقراطية أساساً للجم النزعات الإنسانية، كما يبدو «الدم» أساسا آخر لإطلاق النزعات الغريزية.
فهل كان العشق المرضي لغوستاف آشنباخ بسبب عدم سيطرة المثل الأخلاقية لطبقته ووجود ثغرة «بوهيمية» في العائلة، أم لسبب نفاقية وابتذال هذه المثل الأخلاقية في صميمها، حيث تُضفى على ذاتها أشكالاً أخلاقية سامية بينما هي في جوهرها وضيعة ومبتذلة؟!
توماس مان لا يقوم بتحليل خلفي موسع لهذه الذهنية وجذورها الفكرية والأخلاقية، بل هو يركز على البطل آشنباخ في قوقعته الفردية، فنجد السرد ينطلق لتتبع حركيته المادية والذهنية في الإعداد للرحلة، ومشاهدة بعض اللقطات العابرة والمهمة. والكاتب لا يراكم هذه المشاهدات اعتباطاً، بل هو يسوقها في تراتبية مقصودة. فإضافة الى اللقطات الهادئة العادية، والتي تعكس جمود العالم الاجتماعي من حوله، فإنه يرى مهرجاً يقوم بحركات خليعة مبتذلة ويكاد يمسه بلسانه الشبق. هذه اللقطة التي دخلت عرضا في سياق الأقصوصة، تعبر عن الازدواجيات المتعددة في حياة طبقة وسطى متجمدة مرائية.
فنزعاتها الجنسية المشبوبة مخفية تحت ستار من الرصانة والنفاق، وحين تتفجر مثل هذه النزعات على شكل مهرج فاضح مبتذل، تدرك القاع الذي تخفيه. كما ان هذه اللقطة العرضية سوف تكون تجسيدا لمسيرة البطل في رحلته القصصية القصيرة. فما كان في البداية على شكل ومضة ساخرة، سيظهر في النهاية على شكل مأساة مؤلمة.
وتغدو الرحلة التي يعتزمها الكاتب وينفذها طريقاً للحرية من زنزانة الحياة البروسية الثقيلة، من أجل إظهار النزعات البوهيمية الوحشية، في قلب هذه الحياة المدعية. اختيار مدينة البندقية للرحلة، ورؤية الصبي الجميل، والانبهار بشكله الملائكي، وقسماته الرائعة، هو تجلٍّ للتناقض الداخلي في الكاتب، حيث الرغبات المحرمة، وكسر الأطر المنافقة للمثالية الأخلاقية المصطنعة، والعودة للغرائز البشعة بدون تزويق جمالي وفكري.
وتتحول هذه العاطفة لدى الكاتب إلى هوس دائم بالفتى، فنجد مشاريعه الكتابية والتأملية وسياحته تتجمد لصالح هذا العشق غير المعقول، ليس فقط لفارق السن الكبير، وإنما لطبيعة العاطفة المريضة.
فكأن كل ذلك البناء الأخلاقي والسياسي البروسي الصارم، مجرد تزويق خارجي، وسرعان ما تظهر النزعات الوحشية المكبوتة.
أليس ذلك هو ما سيجري في ألمانيا لاحقا، بدخولها الحرب العالمية الأولى ثم ظهور هتلر، كممثل الذروة لهذه الوحشية البوهيمية المعششة في عظام الغرائز البروسية الأرستقراطية؟
إن توماس مان يضع يده على البذور الأولى للتجليات الصراعية في الوعي الألماني، ولكنه يمسكها بصورة خافتة ومحدودة. وليس ذلك إلا للفردانية الشديدة التي أغرق فيها البطل المحوري، ومحدودية الشبكة الحدثية والشخصانية التي يتحرك فيها.
فالسرد عبارة عن تأمل مستمر للمدينة وللفتى، ومناورات حدثية للاقتراب من الصبي وعدم الانفضاح، ما يغرق البنية المشهدية المتتالية في رتابة، تعوضها بعض الشيء اللغة السردية الشعرية العالية، وتجسيد أشكال الوعي «الرفيعة» للكاتب وتصوراته، ثم تفجير سلسلة الأحداث في النهاية، بدخول مرض الكوليرا القادم من الهند إلى البندقية. ويتحول مرض الكوليرا الى نذير شؤم ليس للبطل فحسب، بل للحضارة الغربية الرأسمالية.
فطيور الموت تحلق، والأوبئة المخيفة تستوطن المدن الجميلة، وتقفز الشواطئ والحانات والشوارع وتظهر الجثث في الساحات وعند المعالم الأثرية الجميلة. ولكن نذير الشؤم يصير فعلاً حقيقياً. فالكاتب الكبير لا يأخذ الإشارات المختلفة التي تنثر أمام شاشة بصره، مأخذ الجد، بل إن الهوى المرضي يستولي عليه، ويجد إشارات مغايرة تنبئ أن الفتى ذاته قد اهتم بهذا العجوز المعذب. إن صور الموت المتفجرة في ختام الأقصوصة هي نذير للحضارة الألمانية وما ستحمله من دمار للبشرية.
«الأقلف» رواية البحريني عبدالله خليفة صورة الآخر البدائية والمكروهة
كتب : نصار سيمون
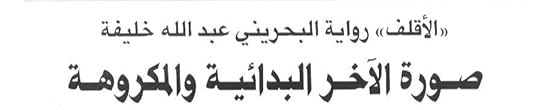
يرمي عبدالله خليفة من خلال روايته «الأقلف» الى تعريف العلاقة البدائية والمشوهة بين الشرق والغرب، المبنية في الأصل اعتماداً على الحروب الاستعمارية ووجود القوات الغربية في بلاد عربية واسلامية بالقوة، ولا ينتهي التعريف عند هذا الحد فقط، إنما يتعداه الى الدخول في حروب استعمارية اخرى لا تهدف الى احتلال الارض بل الى احتلال النفوس والأرواح البشرية وهذه بحسب ما يدعي صاحب «الأقلف» الحروب التبشيرية التي لم تكن بنظره أقل دناءة من حروب الجيوش العسكرية، وبنظرنا ايضا، ولكنه في معرض تناوله قضية «التبشير» يرتكب مجموعة من الأخطاء الأخلاقية تجاه مؤسسات التبشير للديانة المسيحية، ويعالجها بمفهوم قريب من أساليب غلاة المتطرفين «الاسلامويين».
تبدأ «الأقلف» بتحليل ظاهرة اجتماعية مستشرية في كل العالم، هي أولاد الزنا او اللقطاء، فالبطل يحيى لقيط، وليس هذا هو فقط اساس تمايزه عن المجتمع الذي تربى وعاش فيه تحت رعاية عجوز خرساء. بل إن تمايزه الوحيد يكمن في انه لم يختن منذ ولادته، ولم ينتبه مجتمعه ولا مربيته الفقيرة الى هذا الأمر «النشاز» بحكمهم، بحيث انه عملياً غير قادر على الزواج بدون ختان، ولا يمكن له ان يعيش الحياة بشكل طبيعي وهو على هذا الشكل، فالعاهرة التي تعرى أمامها بعد ان خلعت هي قفطانها، رفضت النوم معه حين انتبهت الى قلفته، ونعتته «بالكافر» النجس، «أنت نجس، أيها الكافر غير المختن» ص 69.
ففي مجتمع اسلامي مصفى ونقي، حتى العاهرة ترفض النوم مع زبون غير مختون، وكأن الختان هو المفتاح الوحيد الى المشهد الخفي لهذا المجتمع، المشهد السفلي الذي يملأه الجنس والدعارة والعاهرات المغطيات أجسادهن بالكامل، والفقر المكشوف والفاضح لكل شيء، يتحول الختان الى أساس للكمال فيه مثلما هو في العهد القديم حيث كان وعد الله للشعب لكي يتميز عن غيره ويأخذ كل شيء أن يختن الشعب بكامله، هذا التميز في مجتمع الرواية يدفع ثمنه يحيى اللقيط الفقير الذي لا يأكل الا على المزابل وينام على الارصفة كغريب بدون عمل او مال او عائلة، حتى صديقه اسحاق الذي عانى من نفس المشكلة بعدما تخلّت عنه العائلة التي كانت تربيه.
ضمن هذا المجتمع المتخلف بكل ما يعني التخلف من جهل وأمية ورداءة.
لم يُنتشل هذا الصبي من وضعه الصعب ومن مرضه والجروح الكبيرة في جسده، من أكله ونومه على المزابل غير مستوصف الارسالية الاميركية التي نقله اسحاق اليه وهو شبه ميت، والمبنى الذي تشغله الارسالية لمعالجة هؤلاء الناس الذين يأكلهم الفقر والعوز، تحول من مكان للعلاج ومداواة الجروح، الى ملجأ لهذا اليتيم وصاحبه.
وعند هذه النقلة في حياة يحيى، بدأت ايديولوجية الكاتب في التعاطي مع المؤسسات «الخدماتية» المسيحية.
التبشير والتعصّب
في المستوصف تمّت عملية شفاء الصبي، ولكنه لم يكن شفاءً صحياً فقط بل هو شفاء من التخلّف والأمية، فقد تمّ تعليمه عند المدرس «ناصيف البستاني» كتب الاسم في النص «نصيف» وهو خاطئ ويمكن ان يكون هذا الخطأ من الطباعة او من كتابته مثلما يلفظ في بلد الكاتب.
وهكذا بدأت عملية تبشيره، فتعلّم اللغة العربية والاجنبية وتعلم الكتاب المقدس، وتم حشر الاستاذ اللبناني بطريقة يُفهم منها ان المسيحي اللبناني مرتبط بالايديولوجيا المسيحية الغربية التي تسعى الى تدمير وزرع الفرقة والانقسام في المجتمعات الاسلامية.
بعد ان ساعدته الممرضة الاميركية «ميري» ونقلته من موقع الفقير المتبطل الى موقع المنتج الذي يعتمد على نفسه ويعتمد عليه في اعمال كثيرة داخل المستوصف، بدأت الممرضة «والراهبة» الشابة تميل اليه جسدياً وتراوده عن نفسه وتحبه، وهي الفتاة الاميركية التي نذرت نفسها لخدمة الرب ورعاية المحتاجين ومن خلال هذا تبشر بدينها «المتسامح» فتقول له لحظة ذهابهم الى الكنيسة ليتعمّد أنها لا تعده بشيء من تحقيق رغباته فيها «أنا امرأة نذرت نفسي للرب» ص71.
ولكن الجملة التي صدمته وبدأ على أساسها يعتبر انه خُدع لا تلبث ان تتغير، وهذه المرأة التي أخذت تعامله بعد ان اغتسل بماء القداسة المسيحية بجفاء، لم تبخل عليه فيما بعد بجسدها، فأصبح يعاشرها حتى حملت منه وهو صبي لا يفهم من الحياة شيئاً ولا يريد منها سوى العطف والحنان، هو إبن الزنا او الحرام الذي يقول لميري «ابي ليس منهم. لوني وزرقة عيوني تفضح انتمائي اليكم. ثمة طيار بذر في أمي بذرة ورحل» ص 84.
هذه هي الحجة التي بات «يحيى» يبرر لنفسه الانتماء الى دين غير الدين الذي تربى وشب عليه، ولكنه رغم النزعة التغييرية هذه دخل الى المسجد عند موت العجوز وصلى عليها كما فعل الجميع «لم يجد نفسه الا في الصلاة، يقف فيها كما يقفون» ص 121، وكأن لاوعيه لا يزال مرتبطاً بماضيه بحبل سري بمجتمع التربية الاولى، فغالبا ما يكون المهتدي غالباً قد بلغ من العمر ما يجعله غير قادر على الانتماء الى دين آخر الا بالشكل فقط.
أما المضمون، أما الهواجس والكوابيس التي تلحقه بانتمائه الاول، فهي المسيطر الاول عليه، ويصبح من الصعب عليه تحويل نفسه الى آخر وتسليمها بالكامل الى عهدة تقاليد اجتماعية ودينية اخرى.
ففي مجتمع ترفض العاهرة فيه النوم مع شخص غير مختون بسبب التزامها بحرفية النصوص الدينية او ما يتراءى لها انه كذلك.
لا يمكن لشاب تحويل نفسه الا حين يتخلص نهائيا من الخوف من الآلهة التي ستحاسبه على فعلته هذه بعد ان حوسب من المجتمع إما بالقتل او النبذ.
وتتحدث الرواية عن مؤسسة ارسالية اميركية، وتتحدث ايضا ان هذه الارسالية «رهبنة».
وينقل الكاتب عن لسان مسؤول المؤسسة الأب السيد تومسون قوله للراهبة الممرضة «أنت يا ميري راهبة قبل ان تكوني ممرضة. لم نحضرك الى هنا لتقيمي علاقات غرامية فاضحة وشائنة» ص111 وأيضا «ألم توقعي على عقد ينص على ان تكرّسي نفسك لخدمة الرب. وأن تنقطعي عن معاشرة الرجال؟» ص 112.
وليكتمل الحوار ينقل عن لسان ميري قولها الذي ردت فيه على كلام الأب «لا أصدّق أبدا انك تقول مثل هذه الكلمات، أكنت ابنتك، طفلتك التي تركض وراءك أينما ذهبت، نجر نفس البشر الى أفخاخنا» ص 112.
هذا الحوار الذي حصل بين ميري والسيد تومسون، فاضح ومعيب ومتعصب لما رواه. خاصة المؤلف فضلا عن انه مبني على قلة المعرفة لا على المعرفة. فالإرساليات الاميركية ليست إرساليات رهبنة لأنها ليست كاثوليكية بل بروتستانتية وليس فيها رهبنة، ولا آباء بل قساوسة يمكنهم الزواج بفضل عدم ايمانهم بالتبتل، وعلى هذا فإن الكاتب لم يتقصّ عملياً مادة روائية بل كتبها بشكل عشوائي وغير جدي نهائياً، وربما ليكشف دون ان ينتبه الى ما يجول في أعماقه من كره وتعصب.
أسئلة وإشكالات
يشير التاريخ الذي يزيل نهاية الرواية انها كتبت في العام 1988، ولا يوجد اية ملاحظة حول التاريخ الذي كتبت فيه، بل حول التاريخ الذي نشرت فيه. ومدى ارتباط تاريخ النشر بأحداث قد تجعل من نشرها الآن لافتة، فهي نُشرت بعد الأحداث التي جرت على شكل تظاهرات في «البحرين» بلد الكاتب بسبب دعم أميركا لإسرائيل على أثر الانتفاضة الفلسطينية، وقد تم اقتحام السفارة الاميركية، وبعد 11 ايلول، وهو اليوم الذي غير الكثير وكشف المسافة بين المفاهيم الغربية والمفاهيم الشرقية والعربية الاسلامية، وأتساءل، لماذا لم يقدم على نشر هذه الرواية إلا بعد هذين الحديثين؟ هل لأنه أيقن ان الزمن مناسب وأن حالة العداء للغرب على اعتبار ان الغرب مسيحي، تبرر النشر وأنه يمكن على اساس ذلك قبول مثل هذه الترّهات التي بدل أن تصحّح ما أفسده الدهر تضيف اليه الصدوع.
إسم الكاتب نصار سيمون
المصدر السفير
التاريخ 2002 – 10 – 3
مسارات ـ حمدة خميس كتب : عبدالله خليفة

ديوان «مسارات» هو الديوان الثالث للشاعرة حمدة خميس، بعد الديوانين الأولين «اعتذار للطفولة» و«ترانيم»، هذا الديوان الجديد يعكس بداية «مسار» جديد بعد الانقطاع المضني عن الكتابة الذي عاشته الشاعرة، بعد طوفان من الهدير الشعري بدءا من نهاية الستينيات، وهذا الاتجاه المساري الجديد يتشكل باتجاه ما يسمى قصيدة النثر، حيث يجري هنا الإلغاء الواسع لموسيقى الشعر، لتحل آليات الشعر الجمالية المتألقة في قوة الصورة وظلالها.
ما هي أسباب هذا الانقطاع عن شعر التفعيلة، ولماذا هذا البروز الكاسح لقصيدة النثر، حيث الابتعاد عن ذلك النهر الجارف للموسيقى ودورها التفجيري للصورة وللبنية الفنية؟
إن ذلك قد يعود إلى أسباب فنية رؤيوية عميقة، من الصعب الوصول إليها، ولكن حسبنا في هذه الومضة الانطباعية أن نقرأ قصائد النثر هذه، وندخل في تلافيف تضاريسها.
القصيدة هنا هي قطعة صغيرة وامضة، مكثفة، عميقة، ذات إيحاءات شتى.
اللغة متبلورة تبلوراً إشعاعياً في تنمية الصورة/ الحالة باتجاه معين.
فالصوت الشعري، صوت الشاعرة، يدور حول مركز وجودها المتنوع الأحاسيس والظاهرات، المضطرب، القلق، الهادئ، حيث الطبيعة التجلي الآخر لوجودها. فالشاعرة هي شجرة داخل هذه الأرض، ذات علاقة أمومية بالضوء والفراشات والأنهار والأفكار والأطفال، وهؤلاء الصغار هم الامتداد الأخصب للطبيعة في تألقها.
لقد كان أساس وعي الشاعرة في الديوان الأول «اعتذار للطفولة» هو الوعي الوجودي، الذي تحول الى الرومانسي الفاعل المغير للحياة.
ولذا تظل «الأنا» الشعرية هي مركز الدائرة، وتصير ظواهر الوجود والصراع الاجتماعي جزءا من فيضها.
ومن هنا فإن استمرار الرؤية الرومانسية وامتداداتها الواقعية، يكوّن الموتيفات والأشخاص والأشياء.

التوتر الانفعالي
لعل تلك المرحلة الماضية يغلب عليها التوتر الانفعالي الكبير، والحرارة الشديدة، مما يجعل الصورة تنمو في عملية احتراق حادة، أما في هذا الديوان الجديد فالصورة مضغوطة، مبلورة عبر تصور عقلي/ انفعالي هادئ ومتوتر.
إن الوعي العقلي يلعب هنا الدور الأساسي في تشكيل اللوحة المكثفة:
(أيها الحب
أيها اللهب السري
في كيمياء الخليقة، أدر نخبك
وانتشلنا
أيها الحب
يا قصيدة الكائنات الجميلة
املأ شعاب الأرض
وانتشر في الصدور
والأصابع والأجساد
لهباً حميمياً
يشتعل بالطمأنينة والجذل) .
إن الوعي العقلي، العاطفي الهادئ، يشكل المخاطبة الشفافة ويدفعها للنمو المتدرج، بلا صخب أو انفجارات حادة، أو انعطافات نحو التحليل الشعري للظاهرات بشكل موسع، إلى اللغة المختزلة واللغة الوامضة ذات العمق الدلالي.
وهذا ما تفعله الشاعرة حمدة خميس في أغلب قصائدها، حيث التكوين المبلور المشع، والصوت الشعري لا ينسحب من العالم الى ذاته، بل هو يمر بالأشياء، ملتقطا الاشارات الموجزة له.
وبشكل حياتي مرتعش بدفق اليومي، وأحيانا بشكل شعاري فوقي لا يدخل تفاصيل التجربة.
ولأن الشاعرة هي شجرة، أو فراشة، ترتبط بصلة القربى بظاهرات الطبيعة، فإن كافة مظاهر الحياة تبدو جزءا من الأرض والربيع. ولكن مظاهر الحياة، منقسمة، متضادة، بين القتلة والمقتولين، اللصوص والثوار، وليس ثمة إسقاط رومانسي على لوحة الحياة الاجتماعية، لتغييب انقساماتها، والقوى الايجابية مرتبطة بالخصب، وأحيانا بشكل مثالي، وأحيانا بشكل واقعي، أي من خيوط الحياة الاجتماعية.
سنجد تغلغلا عميقاً بالطبيعة، يتجاوز الموقف الرومانسي الكلاسيكي، عبر الجمع بين ما هو كوني وبشري:
(خطوة لخطورة البحر)،
(أودية الحبر والدفاتر)،
(وقلبي مدجج بالصباح)،
(للبيت رائحة الثوم)،
(ولها بهارات الغضب)… الخ.
إن كل الصور تنمو في غابة الأغصان والعصافير، محيلة الانساني إلى طبيعي، والطبيعي الى إنساني، عبر هذا الدفق الروحي المتلون.
إن كافة الأحجار والأزهار تطلع من أصابعها.

الأمومة
ومن هنا كانت الأمومة ونتاجها الثمري هي أخصب الجهات، ان العديد من المقطوعات مهداة للأطفال ومصورة نموهم ونضجهم، ان مركزية الشاعرة تدور هنا بقوة حول الأفلاك، فهذا الخروج من الذات الى الآخر، يتشكل هنا باتساع أكبر وحميمية أقوى.
عبر صور الحياة اليومية وشعاع الطبيعة. لكن هناك شعارية تقف في وجه نمو التجربة ودخولها الحميم إلى التناقض أساس الفعل الفني ونمو الصورة. فنحن في قصيدة «نصائح» نجد لافتات، لم تنم في تجربة ملموسة وعبر ذلك الاصطخاب الصوري المشع، رغم ابتكار الصورة. إن صور الشاعر القوية تنمو عبر التناقض، ففي قصيدة «امرأة»، نجد الاختزال الشعري وهو يشكل لوحة أخاذة، متفجرة الصور، عبر هذا التضاد العميق الداخلي بين الرجل والمرأة.
ان هذا التناقض يتمظهر أولاً في المطبخ ويتحول البيت كله إلى تنور، وتنغرز الرماح في الذات.
إن المدهش هنا هو بلاغة الصور الكثيفة، الواضحة، الغامضة، التي تترك فجوة كبيرة للظلال، ولتأتي الصور الأخرى توسع هذا الصدام بين المرأة/ البيت، المرأة/ الرجل.
ولنقرأ هذه الصورة البلاغية المقدمة كلغم أولي:
(طعام ينضج على النار
ورائحة الاحتراق تتصاعد من أعماقها).
انه الاستخدام لليومي والطبيعي لكشف الروحي، الذي تتراكم لتشكيله الجزئيات مثل انحباس المرأة بين الثوم وشتات البيت ولتصل الى الاصطدام بالرجل وقيوده، حتى تنفتح القصيدة بتوجه المرأة الى حديقة الجيران لتفاجأ بوجود الشمس .
إن حمدة خميس تغدو حميمية شفافة حين تحيل تجربتها الى صورة وتغرسها في حمم صراعها الداخلي/الخارجي المفتوح على استعباد المرأة والتخلف والغربة، ولكن اللغة تتحول الى لافتات مباشرة حين تتكلم من فوق المنبر:
(انتظروا أيها الرفاق
هائنذا أجيئكم بحكمة الأنوثة وأسرار البذار)،
إن هذه الكلمات مرشوشة بصور مبتكرة، لكن الخطاب يبدو فوقياً متعالياً، بلا نار التجربة.
إنها لا تدع التحليل الشعري، عبر الصدامات والتناقض، يأخذ سيرورته الداخلية في هذه الخطبة، لتنفجر صور الحياة ولتكسر إيقاع الحكمة.
إن من أهم قصائد الديوان قصيدة «الضلالة» ص 55، فنحن هنا أمام مشاهد متوترة، غنية بالتصادم والحيوية، حيث تستعين بتقنية البورتريه والقصة القصيرة، فهي لوحة غنية بالتشكيل والتلون.
فكل صورها انفجار وذات غور نفسي بعيد، تنمي اللوحة الصراعية المتوترة.
قسم «البورتريه» الأول هو وجه الرجل البطل قبل قدومه، والقسم الآخر هو نزوله من تلك العلياء إلى أرض الواقع، أي تحت عين الشاعرة.
ملامح الرجل بدءا هي أسطورية، تموزية، فهو ليس إنسانا ملموسا، بل فكرة مشعة نورانية، تعلقه النساء خرزاً وتمائم في أعناق الأطفال، وهو بذور الربيع القادم، وخطط النبي يوسف للمجاعات المقبلة، هو كائن لا إنساني، فكرة مجردة، لا تتموضع في جسد ما، بل ان تلك الفكرة تسبح في الطبيعة وتصير مولودا منها، وتغدو دفقا في اللغة والبذار والمواسم.
وتؤدي كلمة «كنتَ» دورها في القطع الزماني، وفي تشكيل لحظتين متضادتين، وإبراز شخصيتين متناقضتين، الأولى في الماضي وفي التصور المثالي للبطل الخارق، والثانية في الحاضر، التي لا تأتي بل لتتدفق الصورة الأولى الماضوية، التي تتسع وتسع، طالعة من رحم الغيب وروح الخلق متجهة إلى الميادين وسياجالاحتمالات فكأننا أمام نبي من القرون السحيقة لا رجل معاصر.
ولتلك الصورة المثالية، البيضاء، النقية، دورها في هذه الشاعرة وذوقها بالفعل، حتى تغدو الشخصية البطولية مثل الصخرة الجليدية النازلة من فوق جبل، حتى تصل إلى الشاعرة وتسقط فوقها.
الصورة البيضاء الرومانسية تتحول الى سواد معتم فجأة، فيغدو فارس الأحلام حلزوناً مذعوراً، ذا أقدام تائهة في الشوارع لكن لجامه قابض على روح المرأة.
إننا لا نجد أي تفاصيل حميمية داخل هذا الوصف القطعي الباتر، والشاعرة تنتقل بحدة، وعبر وعي غير جدلي، إلى منطقة شديدة العتمة للرجل «البطل».
ويبدو كلا التصورين غير موضوعي فنياً، بالرغم من أن القصيدة شديدة الحرارة، وهامة فنياً، عبر هذا المعمار البنائي الجميل ذي الحيوية.
إن التضادات بين الشخصيتين يجعلهما تقعان في التجريد الطبيعي، أو الاجماعي، فالبطل هو «شهوة الحدائق» و«عنفوان الصباح» فكيف يتجسد هذا بشرياً؟ إن تجربة حمدة خميس في «مسارات» كبيرة وذات جوانب أخرى عديدة، وهي مليئة بالانجازات ومحفوفة بالمخاطر كذلك، لكنها إضافة هامة لشاعرة تواصل مسيرة الشعر بمعاناة خاصة.
ويطول اليوم أكثر من قرن :جنكيز ايتماتوف ـ كتب : عبدالله خليفة
ما الذي يميز روايات الكاتب والروائي «جنكيز ايتماتوف»، وخصوصاً عمله المترجم الاخير الى العربية «ويطول اليوم اكثر من قرن»؟ وهل استطاع هذا الكاتب القرغيزي «السوفياتي»، ان يصعد بعمله الروائي، الى ذرى الاستبصار والاكتشاف للتحولات العميقة في وطنه المترامي الاطراف، المعقد السيرورة؟ هناك تنبؤات عديدة في اعماله الروائية الابداعية السابقة، تلمح الى ان سوسة البيروقراطية، الجمود الطفيلية، تظهر صغيرة هنا وهناك.
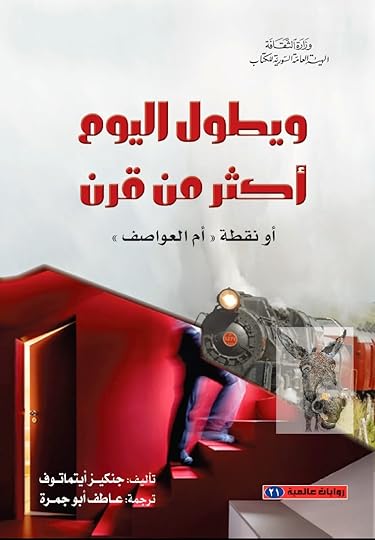
ثمة ارهاصات هامة في «وداعاً يا غولساري». وفي «النطع» ثمة قفزة هامة نحو تحليل واكتشاف هذه القوة المعرقلة للتطور. ولكن هذا كله يبدو بشكل مبسط فنياً، مع استخدام عناصر اجتماعية فاسدة صغيرة هنا او هناك. ان التطور الاجتماعي الروحي، المتناقض، المعقد، باشكالياته الاساسية، بدا خافتاً وبرعمياً في روايات ايتماتوف.
وفي روايته الاخيرة «ويطول اليوم اكثر من قرن»، الصادرة والمترجمة عن دار «رادوغا»، اوسع تطورا لتلك العناصر النقدية البرعمية، لمجمل استنتاجات وتعميمات ايتماتوف الفنية، بشأن التطور في بلده.
ثمة مضمار روائي سابق تم استخدامه هنا في هذا العمل وتم التوسع فيه، فبدلاً من ان يكون «غولساري» الحصان المحتضر، وسلسلة الذكريات المصاحبة للعلاقة الطويلة معه، فان البطل هنا، يديغي البوراني هو ايضاً يودع صديقاً قديماً شغيلاً الى مثواه الاخير، وتنشأ الذكريات وتنهال اثناء لحظات الوداع.
ان هذه الطريقة الفنية تتيح تعدد صور الذكريات، التي تبدأ من لحظة الوفاة،الى صورة المحطة وتاريخها، وانعزالها وعمالها القليلون وعلاقة البطل المحوري «يديغي» بشخصيات المحطة المختلفة، وتاريخه وعلاقته بزوجته..
ان هذا النمو الفني يوسع شبكة العلاقات، وتصوير الطبيعة والتغلغل في التاريخ القريب للشخصيات الاساسية في الرواية، ولكنه من جهة اخرى، يجعله تراكمياً، وكثير التفاصيل. ولا تغدو مسيرة دفن الجثة في مقبرة آنا رباييت، الا احدى مفاصل الرواية. بينما كان الحصان غولساري في وداعاً يا غولساري مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بحياة البطل وعمله.
وكان هو النسيج الاساسي في الرواية ورمزها المشع وبؤرة احداثها.
هنا تتعدد الثيمات وتتراكم الذكريات في جهات مختلفة.
فهناك الميت كازانفاب وعملية دفنه التي تواجه بعض الصعوبات، ثم هناك محور آخر هام لا يتصل عضوياً بحادث الموت، لكنه ينهل من ذكريات وحياة يديغي نفسه.
فأبو طالب قطبايف كان هو الآخر عاملاً لجأ الى هذه المحطة النائية وعاش فيها مع عائلته وزوجته ظريفة.
لكن نظراً لكونه اسيراً سابقاً عند الالمان في الحرب العالمية الثانية، وهارباً من اسرهم ومقاتلاً في صفوف الانصار اليوغسلاف، فانه يتعرض للاضطهاد من قبل المخابرات ويوضع في السجن.
ان ايتماتوف يقوم بتشتيت عناصر الرواية، فتترهل اجزاؤها وتغدو البؤرة المركزية، بؤراً متعددة، فتتحول الرواية الى قصص متعددة. وذلك يعود لان الصراع الاساسي الذي تفجر في البدء، بين يديغي وأبي طالب خصوصاً وغيرهما، ضد جوانب الشر الاجتماعي في المجتمع، قد تحول الى قضية فردية، وهامشية. وصار نقداً جزئياً للواقع، بدلاً من التغلغل الواسع في المجتمع وكشف مشكلاته المحورية، التي تفجرت فيما بعد بشكل، يجعل ذلك النقد الجزئي، ضيقاً ومحدوداً.
ان اختيارات الكاتب، لهذه البقعة الهامشية، محطة القطارات النائية، وشخصياته الشعبية المغمورة، وعدم وجود محور صراعي واسع وعميق، ادى الى تشتت العنصر الروائي الملحمي، وظهور عنصر قصصي قصير متعدد ومتراكم. من هنا اتسع وصف الطبيعة عبر لوحات جميلة مختلفة، وظهرت صور الحيوانات وحكاياتها، اذ ان عدم اللجوء الى الابطال، وانغراسهم في تربة يومية ضيقة، ضيّق دلالات الرواية، وحولها الى نقد جزئي محدود.
اما ادخاله للحكاية الفضائية فهذا باب جديد يطرقه ايتماتوف ولكن يعبر عن مشكلة روائية في عالمه الفني. فقد رتب في سياق رواية يديغي، حكاية خيالية عن اكتشاف كوكب جديد هو «الصدر الغابي» الذي توجد فيه حضارة «انسانية» عليا.
ولكن المسؤولين عن الامن الكوكبي في عالمنا «الاتحاد السوفيتي» و«اميركا» يطلقان صواريخ متعددة لمنع الالتقاء بهذه الحضارة، ويرفضان عودة رائدي الفضاء اللذين اتصال بتلك الحضارة العليا. ان ادخال هذا العنصر الجديد، يشير كذلك الى تراكمية العناصر الفنية في رواية ايتماتوف. ولقد حاول المؤلف، عبر هذا العنصر، ان يعطي لعمله دلالات فلسفية.
ليقول ان الارض الآن في حاجة الى تعاون مغاير وانساني. مما يمثل اصداء لمقولات «التنكير الجديد».
ان التغيرات الضخمة التي وقعت في «الاتحاد السوفياتي» تجعل مثل هذا الادب النقدي قاصراً بشكل كبير عن رؤية التيارات الصاخبة في القاع والمشكلات الحادة المتراكمة في العمق.
وهذا لا يعود فقط الى تفكير الروائي ايتماتوف، الذي يواكب تطورات الوعي النقدي داخل جهاز الدولة، ويقيد وعيه بمقولاته السياسية المباشرة، بل ايضاً الى طابع الرواية الذي اختطه، بالتوجه الى بؤر هامشية، والقاء ظلال نقدية محدودة حول النظام الاجتماعي.
فهو لا يتوجه الى البؤر المركزية، الى عمق جهاز الدولة نفسه، او الصراعات الاساسية في المجتمع ويقوم بتشريحها.. متسائلاً: لماذا انعزلت عنه الجماهير، ولماذا صعدت التيارات المثالية والدينية والقومية اليس ذلك نتاجاً لازمة بنيوية في النظام، عبر استئثار الارستقراطية الحزبية والدولية بالمنافع والحقيقة والقرار؟
لماذا لم تتجه روايات ايتماتوف، عبر العقود الماضية، الى مثل هذا التشريع وبقي، في احايين عديدة، في بقع بعيدة، شاعرية، اليس هذا الوعي نفسه جزءاً من الوعي المسؤول عن الازمة؟!
من هنا نجد ان تشتت العناصر الروائية، وكثرة اللوحات الجانبية، وهامشية المحور القصصي، كلها جزء من نظرة فنية تتجنب الدخول حتى الآن الى تشريح الازمة، داخل جهاز الدولة جهاز الحزب، ورؤية التناقضات بين مستويات المعيشة والتفكير والاحلام بين النخبة والشعب.
June 14, 2024
قراءة في رواية: الاقلف
كتب: أحمد العربي
عبدالله خليفة روائي بحريني متميز، يكتب منذ سبعينيات القرن الماضي، له العديد من الروايات والمجموعات القصصية، هذا اول عمل نقرأه له.
الاقلف، رواية كُتبت في عام ١٩٨٨م، ونشرت في عام ٢٠٠٢م.
تبدأ الرواية من وصف حياة الطفل الصغير يحيى، الذي يعيش في عشّة صغيرة في مزابل المدينة، تحتضنه الجدة، تلك المرأة العجوز الخرساء، التي وعى يحيى نفسه على الدنيا وهو يعيش في المزابل بصحبة الجدة وحمايتها، ينبش واياها في المزابل باحثا عن بقايا طعام وملابس واشياء ينتفع بها، ليعيشا عليها، يتصارع مع الكلاب الشاردة والاطفال الآخرين أمثاله من لقطاء المدينة وفقرائها وأيتامها. كان للآخرين دور في قدرته على تعلم النطق والتحدث، كان أقرب للخرس كما الجدة، بقي كل عمره ضنين الكلام، يعيش مشاعره موّارة في نفسه. استجد على حياة يحيى حضور شاب يكبره الى المزابل ومعه عربة يجمع عليها بقايا الانقاض وبعض ما يباع لاعادة تدويره.
تبادل الشاب مع يحيى الرصد المتبادل، سرعان ما اندفع الشاب اتجاه يحيى وعرفّه بنفسه، اسمه اسحاق، من اسرة ثرية وله عدد كبير من الاخوة والاخوات، كبر بينهم، ومع كبره ونضجه أصبحوا يعاملونه بطريقة تمييزية، لم يسمحوا له بإكمال تعليمه، وبدؤوا يوكلون إليه الأعمال القاسية والخدمية للعائلة، لقد أحس بدونية بينهم لم يفهم سببها، وعندما واجههم بتلك المعاملة، اخبروه انه ليس ابنهم انه مجرد لقيط وجدوه على باب الجامع. فُجع إسحاق بمعرفة حقيقة حاله، غادرهم غير آسف وبدأ يعمل في جمع الأنقاض من المزابل وبيعها ويعيش حياة شقاء وفقر.
أما يحيى فقد اخبره انه لا يعرف عن نفسه إلا أنه ابن هذه المزابل وجدته الخرساء، وانه لقيط رمته امه هنا لتحمي نفسها من عار او انتقام، أدرك يحيى انه بلون عيونه الزرقاء وبشرته البيضاء، قد يكون ابنا لأحد هؤلاء الجند الانكليز الذين يحتلون البحرين ويعيثون فيها فسادا.
تصاحب يحيى وإسحاق وبدءا العمل على عربة إسحاق، يجمعان ما يتوفر لهما، ويذهبان به للسوق ويبيعانه بدراهم قليلة تفيد بطعام نظيف واحساس بالانسانية اكثر من النبش بالمزابل والعيش على فضلاتها. استمر الحال على حاله ذلك الى أن جُرح يحيى ذات مرة أثناء النبش في المزابل، وأخذه اسحاق الى المشفى الأمريكي في المدينة، المشفى الذي يعالج بالمجّان وتديرة ارسالية تبشيرية مسيحية، استقبلتهم الممرضة ايمي وهي ايضا راهبة. وقعت ايمي منذ اللحظة الاولى في غرام يحيى، واهتمت به كثيرا. أطالت فترة علاجه، حاولت أن تستميله وإسحاق للالتحاق بالمشفى يقومون ببعض الخدمات، وتهتم بهم تخضعهم للتعليم والتأثير الديني ليكونوا مسيحيين، كانت ايمي جزء من ارسالية دينية تتغطى مع غيرها بالعمل الصحي لتنصير هؤلاء “الوثنيين” على حد تعبيرها.
رفض يحيى وإسحاق ذلك، وتركاها مع الفرصة التي قدمتها لهم، طعام لذيذ ومأوى مناسب وعمل محترم وتعليم وتلقي مبادئ الدين المسيحي. يحيى احسّ اتجاه ايمي مشاعر خاصة لعله الحب، يحيى لا مشكلة عنده في موضوع الدين، فهو ابن المزابل وجدته الخرساء، لم يلقنه احد يوما دينا معينا، علاقته مع الله والدين ضبابية، مسكون بهاجس المظلومية التي أوجدته لقيطا في مزابل المدينة، لكن اسحاق كان مدركا لحقيقة ما تريد منهما ايمي وبقية فريقها الطبي. لكن الحاجة للمشفى استمرت، عاد يحيى وإسحاق يحملان على عربتهم الجدة التي مرضت واحتاجت للعلاج. وكان تأثر يحيى بإيمي هذه المرة أكثر، رضي أن يلتحق بالعمل بالمشفى و تعلم القراءة والكتابة والدين المسيحي، وجد ذاته باللغة التي امتلك ناصية حروفها، وبالاله المسيح المصلوب لأجل خلاص البشرية من الذنوب.
ابتعد إسحاق عن يحيى وهو يعاديه، اعتبره خائنا لدينه الإسلام ولشعبه في البحرين. تعلق يحيى وإيمي ببعضهم في حب قوي، لكنهما بقيا على مسافة جسدية عن بعضهم. كانت ايمي ابنة لعائلة ثرية امريكية، عاشت طفولتها وبداية نضجها بسعادة بين أهلها، لكن والدها بدأ التحرش الجنسي بها، فما كان منها الا أن قررت الالتحاق بالكنيسة، ترهبنت وجاءت إلى البحرين مع فريق طبعي تبشيري، كان الاتفاق معها على أن تلغي عواطفها الذاتية و حاجاتها الجسدية وتعطي نفسها للتبشير المسيحي. لكن يحيى أيقظ فيها مشاعر الحب، والحاجة للجنس مع الآخر رغم عقدتها من والدها، راقب مديرها رئيس البعثة تحولات إيمي وطلب منها أن تبتعد عن يحيى وأن تستمر مخلصة لدورها وتعهدها، صحيح انها دفعت يحيى للتعليم، وأن يعلن انتماؤه للدين المسيحي، ويعّمد في الكنيسة التابعة للارسالية، لقد اخبرها مسؤولها ان هذا كافي، لكن يحيى وإيمي وصلا بعلاقتهما إلى مرحلة اللاعودة واقتنعا ببعضهما وعاشا علاقة جسدية كاملة كزوجين.
اما إسحاق فقد حمّل نفسه مسؤولية معاقبة يحيى عن تنصره وخيانة اهله وناسه، واجهه في احدى المرات وطلب منه العودة عن تنصره وأن يتوب الى الله، لم يستجب يحيى للطلب، طعنه اسحاق في صدره وهرب، تم اسعاف يحيى وانقاذه من الموت المحقق، مما ضاعف العلاقة والحاجة بين إيمي ويحيى. طُردت ايمي من العمل، ذهبت الى بيت يحيى الذي كان قد استأجره بعد عمله في المشفى، وعاشا سويا وسط أجواء عداء عامة. لم تكن الحالة في البحرين مقبولة على مستوى شعبها، لقد كان المستعمر الانكليزي وجنده مسيطرا على البلد ومقدراته، والشعب يعيش الفقر والفاقة.
بدأ بعض الشباب بالعمل للثورة على هذا الوجود المستعمر، كان إسحاق على رأسهم، بدؤوا بأعمال عنف بحق الانكليز ومن والاهم، كان لليهود أبناء البلاد نصيب من التنكيل، قتل ونهب وإحراق بيوت، كان انتقاما اعمى. حاول يحيى ان يصل لصديقه القديم حتى يوضح له أنه وإيمي لم يعودوا مع الارسالية وطردوا من المشفى. لم يتمكن من ذلك. كان رد المستعمر الانكليزي قاسيا فقد بدء في ضرب الاحياء وحرقها ردا على ثورة الناس. كان يحيى يحتمي في بيته مع إيمي التي حملت وأنجبت له طفلة اسمها عائشة. هجمات الانكليز واحراقهم البيوت وصل لبيته، احترقت زوجته إيمي وانقذت الطفلة، احسّ يحيى بالكارثة التي احاقت به، احس انه مسكون بالظلم منذ مجيئه الى الدنيا لقيطا. وان زوجته أيمي وابنته عائشة هما النور الوحيد في حياته، لكنه خسره.
احتضن طفلته بعد احتراق زوجته، لكن قائد الجند الإنكليزي اختطف الطفلة وطلب منه ان يأخذهم إلى حيث يعيش صديقه القديم إسحاق، الذي أصبح زعيما للمتمردين الثوار. كان يحيى جاهلا بمكان إسحاق، ولم يقبل ان يخون صديقه ومطالبه المحقة، أخذهم في متاهات المدينة ولم يوصلهم الى شيء، أطلق الانكليز عليه النار، ادموه ثم شنقوه.
هنا تنتهي الرواية
في تحليلها نقول:
بداية أن لغة الرواية واسلوبها جميل جدا، جزل، مليء بالصور والتشابيه، يومئ لما يريد الوصول اليه، يبتعد عن المباشرة والتبشيرية والتعابير الكبيرة، يجعلك كقارئ تصل للمعلومة ضمنيا، بكثير من السلاسة والراحة.
.الرواية مكتوبة بلغة السرد عن واقع تغوص فيه بذاتيات شخوصه، بعمق وشفافية، لكنها تمر على الجانب العام المجتمعي للبحرين المحتل من الانكليز، بمقدار مايمس ذلك الواقع هؤلاء الأشخاص، راسمة أقدارهم بكل دقة وحرفية. المجتمع البحريني الفارق بالفقر والامية والفاقة، مجتمع قائم بذاته في المزابل، قاع قاع المجتمع، حياة البشر الكثر الذين يعيشون على النبش في الفضلات، وجزء آخر من المجتمع يتمثل بيهود البحرين على علاقة مع المستعمر والإرساليات التبشيرية ممتلئ بالمال والالتحاق بالانكليزي والغرب ومصالحهم، حضور الانكليز الطاغي بصفتهم حكام القلعة، عسكر وقتل واعتقال وبطش. شعب بدأ رحلة النضال لتحقيق الحرية عبر عمليات عنف طالت الانكليز واذنابهم من اليهود وغيرهم. وسط كل هذا تنشأ حالات انسانية من حب الأضداد يحيى اللقيط الفقير وإيمي ابنة التبشير، لا يخفى استحالة هذا الحب، رغم كون ايمي هربت من تحرش والدها الى الرهبنة والتبشير والتمريض، وان يحيى وكونه ابنا للمزابل ولا وطن له. مع ذلك حاسبه المستعمر بكونه صديقا لزعيم الثوار. نعم لا يستطيع أي أحد أن يخرج او يهرب من شروطه الحياتية العامة والخاصة. لذلك حُرقت أيمي مع الحي الثائر من قبل المستعمر واعدم يحيى صديق الثوار.
اخيرا نقول ان الحياة المعاشة في أي مجتمع في أي وقت طالما أنها ملوثة بالمظلومية و اللاعدالة و وجود المستعمر والحاكم الظالم المستبد ستبقى دائما حياة لا انسانية. وتبقى الثورة على المستعمر و الفقر واللامساواة والاستبداد قانون يحرك البشر في كل زمان ومكان. هذا ما قاله الواقع العربي بعد عقود من زمن كتابة الرواية. حيث حصلت الثورة لتحقيق الحرية والعدالة والديمقراطية والحياة الأفضل لكل الناس في بلدان عربية كثيرة.
June 2, 2024
ملامح 1 : عبـــــــدالله خلــــــــيفة
عبدالله خليفة، بصفته روائيًا
بحرينيًا متميزًا، يُعرف بدمج تجاربه الشخصية والحياتية في كتاباته، مما يُضفي على أعماله طابعًا واقعيًا وعمقًا فكريًا. يُشير النقاد إلى أن خليفة استخدم تجاربه الشخصية كوسيلة للتعبير عن هموم الأرض والوطن والبسطاء1. وقد تميزت كتاباته بالجهود الفكرية والبحوث التاريخية والفلسفية، مما يعكس تجربته الغنية والمتنوعة2.
من الجدير بالذكر أن خليفة قد عاش تجارب مؤثرة، مثل اعتقاله من سنة 1975 إلى 1981، وهو ما يُعتقد أنه أثر في كتاباته وأسلوبه الأدبي3. كما أنه قضى سنوات في القراءة والبحث الذاتي، مما ساهم في تشكيل فهمه ونظرته الأدبية4.
تُعد أعماله مرآة للمجتمع البحريني والعربي، تعكس تجاربه وتحدياته بصدق وعمق، وتُظهر كيف يمكن للأدب أن يكون وسيلة للتعبير عن الذات والهوية الثقافية.
عبدالله خليفة، بصفته أحد أبرز الكتاب في الخليج والوطن العربي، تناول في كتاباته مجموعة واسعة من القضايا الهامة التي تعكس تجاربه الشخصية والاجتماعية. من أهم القضايا التي تميزت بها أعماله:
الهوية والانتماء: يستكشف خليفة مفاهيم الهوية والانتماء من خلال شخصياته التي تعيش تجارب متنوعة، معبرًا عن الصراعات الداخلية والخارجية التي تواجهها1.
التاريخ والتراث: يغوص في أعماق التاريخ والتراث البحريني والعربي، مقدمًا رؤية نقدية للأحداث التاريخية وكيفية تأثيرها على الحاضر2.
القضايا الاجتماعية والسياسية: يتطرق إلى القضايا الاجتماعية والسياسية مثل العدالة، الحرية، والتغيير الاجتماعي، مع التركيز على الطبقات المهمشة والفقيرة3.
الصراع الإنساني: يعالج الصراعات الإنسانية والوجودية، مثل البحث عن الذات، الحب، والخسارة، بأسلوب يجمع بين الواقعية والرمزية4.
النضال والمقاومة: يبرز في كتاباته موضوع النضال والمقاومة ضد الظلم والاستبداد، مستلهمًا من تجاربه الشخصية في السجن 5.
تُظهر هذه القضايا التزام خليفة بالكتابة كوسيلة للتعبير عن القضايا الإنسانية والتحديات التي تواجه المجتمع، وتعكس رؤيته الأدبية العميقة والمتجذرة في الواقع البحريني والعربي.
ملامح : عبـــــــدالله خلــــــــيفة
عبدالله خليفة، بصفته روائيًا
بحرينيًا متميزًا، يُعرف بدمج تجاربه الشخصية والحياتية في كتاباته، مما يُضفي على أعماله طابعًا واقعيًا وعمقًا فكريًا. يُشير النقاد إلى أن خليفة استخدم تجاربه الشخصية كوسيلة للتعبير عن هموم الأرض والوطن والبسطاء1. وقد تميزت كتاباته بالجهود الفكرية والبحوث التاريخية والفلسفية، مما يعكس تجربته الغنية والمتنوعة2.
من الجدير بالذكر أن خليفة قد عاش تجارب مؤثرة، مثل اعتقاله من سنة 1975 إلى 1981، وهو ما يُعتقد أنه أثر في كتاباته وأسلوبه الأدبي3. كما أنه قضى سنوات في القراءة والبحث الذاتي، مما ساهم في تشكيل فهمه ونظرته الأدبية4.
تُعد أعماله مرآة للمجتمع البحريني والعربي، تعكس تجاربه وتحدياته بصدق وعمق، وتُظهر كيف يمكن للأدب أن يكون وسيلة للتعبير عن الذات والهوية الثقافية.
عبدالله خليفة، بصفته أحد أبرز الكتاب في الخليج والوطن العربي، تناول في كتاباته مجموعة واسعة من القضايا الهامة التي تعكس تجاربه الشخصية والاجتماعية. من أهم القضايا التي تميزت بها أعماله:
الهوية والانتماء: يستكشف خليفة مفاهيم الهوية والانتماء من خلال شخصياته التي تعيش تجارب متنوعة، معبرًا عن الصراعات الداخلية والخارجية التي تواجهها1.
التاريخ والتراث: يغوص في أعماق التاريخ والتراث البحريني والعربي، مقدمًا رؤية نقدية للأحداث التاريخية وكيفية تأثيرها على الحاضر2.
القضايا الاجتماعية والسياسية: يتطرق إلى القضايا الاجتماعية والسياسية مثل العدالة، الحرية، والتغيير الاجتماعي، مع التركيز على الطبقات المهمشة والفقيرة3.
الصراع الإنساني: يعالج الصراعات الإنسانية والوجودية، مثل البحث عن الذات، الحب، والخسارة، بأسلوب يجمع بين الواقعية والرمزية4.
النضال والمقاومة: يبرز في كتاباته موضوع النضال والمقاومة ضد الظلم والاستبداد، مستلهمًا من تجاربه الشخصية في السجن 5.
تُظهر هذه القضايا التزام خليفة بالكتابة كوسيلة للتعبير عن القضايا الإنسانية والتحديات التي تواجه المجتمع، وتعكس رؤيته الأدبية العميقة والمتجذرة في الواقع البحريني والعربي.



