الرواية بين الإمارات والكويت (1 من 4) : كتب ــ عبدالله خليفة
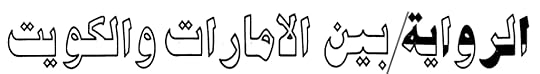
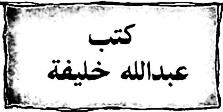
لم تظهر الرواية في الخليج العربي إلا في العقود الثلاثة الاخيرة من القرن العشرين.
وبشكل محدود وقليل، وقد سبق أن ظهرت روايات نادرة في لحظات متفرقة، متباعدة، مثل رواية «ملائكة الجبل الأخضر» . لعبدالله محمد الطائي وغيرها، إلا أن الظهور الأخير للرواية العربية في منطقة الخليج، كان الأكثر ديمومة وفنية.
ان هذا الظهور المتأخر، والنادر للرواية في الخليج، يعود إلى تأخر النهضة الاجتماعية في المنطقة، وبروزها بشكل خافت، في منتصف القرن، ثم انفجارها في العقود الاخيرة.
وحتى فن القصة القصيرة، الرديف الآخر لفن الرواية، ظهر متاخراً ومحدوداً، ومتقطعاً، ليبدأ تطوره السريع والعميق في ذات الفترة التي بدأت تتشكل فيها بذور الرواية.
إن ارتباط فن الرواية، بعمليات التطور العميقة الحديثة في البُنى الاجتماعية . قد صار أمرا مقررا ومعروفا، منذ أن قيل إن الرواية «ملحمة المجتمع البرجوازي» فمع تصاعد دور الطبقة المتوسطة، وقيامها بتحديث المجتمع، وتغيير بنيته الاقطاعية القديمة، واتجاهها لمركزة المجتمع المشتت، وخلخلة تركيبته المتخلفة وتحديثها، تبدأ الفنون الحديثة، وخاصة الرواية، في تركز أجزائها وبلورة كليتها العضوية، وقدراتها في استيعاب تطورات الواقع وتناقضاته.
وتحدث توجهات عدة في عملية استيعاب الواقع، تبعا للمواقف الاجتماعية المختلفة والرؤى الشخصية ومستويات تطور كل بلد على حدة، و تتضافر تأثيرات فنية مختلفة، عربية وعالمية، في رفد هذه العملية المعقدة .
ويبدو واقع الخليج العربي، بسيطا في تشكيل هذه العملية الاجتماعية الفنية، سواء من حيث حداثة النشاة الروائية، أو في قلة انتاجه في هذا النوع الإبداعي.
فقد بدأت المدن الخليجية مؤخراً، مثل الكويت، المنامة، دبي، ابوظبي، الشارقة، الدمام الخ .. في التحول الى مدن عصرية كبيرة، وراحت بُنى الدول الحديثة تتمركز. وتنمو قطاعاتها الاقتصادية، وتتشكل طبقات حديثة راحت تنتج اشكالاً متعددة من الآداب والفنون .
وكانت الكويت، والبحرين، مسرعتين في هذا التبلور الاجتماعي، ونمو الوعي الفني، نتيجة لبدء استخراج النفط فيهما مبكراً،وبسبب صغر حجم البلدين وتسارع نمو بنيتهما بصورة اكبر من الدول الأخرى، وتشكل طبقة متوسطة منذ العقود الأولى للقرن العشرين.
ثم لحقتهما دولة الإمارات في عملية التطور الاجتماعي، وبصورة سريعة، وشاملة، مما أدى إلى تنامي أشكال الوعي الفني المختلفة في المنطقة. وتواكبت مع هذه التطورات نهضة الانواع النثرية وخاصة القصة القصيرة والمسرحية. فنجد أن بدايات الحركة القصصية القصيرة تلاح منذ الخمسينات، ثم تتدفق في السبعينات، وتتجه في أغلبها الأعم ، إلى التقاط نماذج مطحونة من البيئة وواقع الحياة، وعبر لقطات مكثفة على ظاهرات التحول.
إن اللقطة الجزئية. والحدث الواحد ، والنموذج المسيطر، هي أساسيات القصة القصيرة، وهذا ما يقودها الى التركيز على الموقف الصغير، واللحظة المقطوعة بسياقات التحول الواسعة، وإشكالات المدن الحديثة العميقة، التي لم تعد فقرا ظاهرا أو مشكلات جزئية محدودة فقط .
كما أن الوعي الفني في الخليج، راح منذ مدة طويلة، يشكل المسرحية، وهى البناء الدرامي المطول، عارضاً مجموعة من النماذج والأحداث في توليفة فنية، تستهدف عرض مشكلات المجتمع البارزة.
إن هذا الوعي الفني نفسه هو الذي راح ينعطف بالقصة القصيرة، نحو القصة الطويلة، أو الرواية، في أعمال متناثرة، لكنها تعبر عن ذات الظاهرة التي يصادفها الوعي الفني في اسئلته المقلقة الحائرة عن التطور.
إن بطء تشكل الرواية في الخليج، وندرة اعدادها، يعبر عن هذا النمو البطيء للتطور، والاتساع الهائل للصحراء والبادية، وضآلة المدن في هذا الامتداد الضخم، وغياب فاعلية الطبقات والمؤسسات الحديثة . فنجد أن دولة ضخمة كالمملكة العربية السعودية لم تشهد إلا ثلاث روايات في سنوات متباعدة من القرن العشرين، ثم لم تظهر الرواية في العقود الثلاثة الاخيرة من النهضة المتسارعة والكبيرة فيها. وكما أوضحنا فقد كان عامل التطور الأكبر في الكويت والبحرين، من الأسباب المؤدية لهذا النهوض الروائي فيهما.
أن المدن البحرية الصغيرة، الكثيفة السكان، الواقعة على طريق تجاري دولي، وفي ظل تطور اقتصادي، وثقافي: متسارع ستشهد هي ميلاد ونمو الرواية. وسيكون لهذه النشأة المدينية بصماتها القوية على موضوعاتها واشكالها ومضامينها.
فهذه المدن البحرية التي كانت جزءا أساسياً من نسيج مجتمع الفوضى، ستبدأ هي، قبل غيرها، في الانفلات من شبكة العلاقات الاجتماعية القديمة وبالإحساس بصدمة التطور والحداثة، أي ازمة التحول من نمط من العلاقات إلى نمط آخر. وكان للنمط الاجتماعي، بعلاقاته الأبوية، ونموه في أحضان الطبيعة «البكر» واشكال علاقاته الجماعية التآلفية والحميمة، ذكرى جميلة واصداء في جانب من الوعي الفني. كما سيكون لهذه العلاقات القديمة ذكرى بغيضة، في جانب آخر من الوعي الفني، سيرى سيرورة علاقات الاستغلال بين مجتمع غوص قديم ذي علاقات متخلفة، ومجتمع رأسمالي غريب التكوين، وحاد الميلاد.
وكما نشأ مجتمع الخليج الحديث من وشائج المجتمع القديم، التي ظلت متشبثة بقوة، فيه، فإن الرواية ولدت من عوالم القصة القصيرة، دون أن تستطيع تماما، تكوين بنيتها المتبلورة.
فكل منتجي الرواية هم، اساسا، كتاب قصة قصيرة، راحوا يطوعون البناء القصصي القصير لعمل روائي موسع، كما فعل وليد الرجيب في «بدرية» حيث حشد عدة قصص قصيرة في عمله الأول، وكما تفعل ليلى العثمان ، في توسيع بنية القصة القصيرة وتمديدها لتشمل موضوعات عدة، في حين يظل المحور القصصي واحدا، والشخصيات قليلة، واللغة الفنية مكثفة وموجزة .
إن نمو الرواية من معطف القصة القصيرة، يدل بوضوح على بكارة النسيج الروائي الخليجي، وعدم وجود في خلفية فنية عميقة يستند عليها في تشكيلته المعاصرة . لهذا فإن معظم الروايات هي من النوع القصير، الذي لا يتجاوز المائة والخمسين صفحة، من القطع الصغير، إلا فيما ندر، ورغم ان روايتي علي ابوالريش: «الاعتراف»، و«الزهرة والسيف»، تتجاوزان هذا العدد، إلا أن بنيتهما الفنية تمتاز بالقصر، رغم الطول الظاهري لعدد الصفحات.
فروايتاه الأولى والثانية رغم اتساعهما الكمي، إلا أن العديد من المشاهد القصصية والحوارات التعليقية زائدة، وكان يمكن ضغط بنيتهما الى درجة كبيرة . راجع فصل (حول التقنية والأحداث).
ويمكن ملاحظة الطابع القصصي القصير المختصر، في رواية محمد حسن الحربي كذلك، حيث لا تتجاوز صفحاتها الخمس والثمانين صفحة. وهي تدور حول عدة شخصيات وأحداث، بصورة وامضة، سريعة، فلم تأخذ الشخصيات والأحداث العديدة، حقها من التشبع الفني. ويمكن ملاحظة سمة القصر والكثافة، في روايات خليجية أخرى لم تبحث هنا، كرواية امين صالح «أغنية أ . ص الأولى»، و«الجذوة» لمحمد عبد الملك وغيرهما.
إن سمة القصر والتكثيف ليست سمات شكلية بحته هنا، بل مرتبطة بالتشكيل الإبداعي. فهذا القصر يقود الى عدم تشبع التحليل الفني للواقع. فالشخصيات القليلة والأحداث الصغيرة، لا تقوم بمد شبكتها الواسعة في الحياة، واكتشاف تعدد مستوياتها وصراعاتها وعوالمها الخفية ووجودها النفسي والروحي، بل هي تركز على جوانب صغيرة، كما فعل علي أبوالريش في روايته الأولى، حين ركزت الرواية على واقع الشخصيات الفردي، وانقطع علاقاتها بما هو خارجها، وحين اتجهت الرواية الثانية الى تحليل المدنية المعاصرة، ومقارنتها بعالم البحر فإنها وقفت على ضفاف المدينة وعوالمها .
كما جاءت روايتا «وسمية تخرج من البحر»، و«المرأة والقطة» لليلى العثمان، مركزتين على حدث يعيش على ضفاف المدينة الخليجية المعاصرة. كان الحدث في الرواية الأولى مركزا على الاتجاه نحو، الحر، والغرق في عوالمه القديمة، الشفافة، التي غدت بديلا رومانسيا عن الواقع المعاصر. وكان الحدث في الرواية الثانية توغلاً في مستشفى أعصاب، عبر نموذج معاصر انكسر نتيجة سيطرة العلاقات الأبوية القديمة. فلم تكن العمة المسيطرة في الرواية، إلا البديل العنيف عن أب ضعيف. وهنا يسيطر موتيف الصراع بين الجدب والخصب، كموتيف تجريدي لا يأخذ لحمه ودمه، من نسيج العلاقات الاجتماعية الحية .
ورغم أن هذا الصراع بين الجدب والخصب، القديم والمعاصر، قد سيطر على رواية وليد الرجيب «بدرية» إلا أن الروائي هنا، أعاد تشكيل هذا الموتيف من عصارة الحياة الشعبية ومن مرارة الأشياء المتعددة المتناقضة، فقد قام باكتشاف بنية المدينة الخليجية، وصراعاتها الاجتماعية ، بين البحارة الذين تحولوا إلى عمال، والنواخذة والطواشين، الذين تحولوا إلى رأسماليين وموظفين كبار .
ومن هنا نجد هذه الحيوية التي تتسم بها رواية الرجيب، التى اتسعت مكاناً وزماناً، كسرت دائرة الانحصار في زاوية محدودة، وركضت شخصياتها بين البحر والمعمل والازقة والمدينة المتحولة النامية .
ان رواية وليد الرجيب تقدم صورة واسعة للمدينة، ونسيجها الداخلي، عبر شبكة صراع شخصية وطبقية، كما تصور المهن والعادات والاحتفالات القديمة، بصورة سريعة أيضا ، وكأن «بدرية»، تحاول أن تصف وتعبر عن كل التطور الحاصل في المجتمع الخليجي، عبر ثلاثين سنة، وفي حجم صغير (عدد صفحات الرواية 132 صفحة من القطع الصغير).
ولهذا فأن هذا الاتساع الكبير، وشمولية الرؤية، بين الماضي والحاضر، بين طبقات المجتمع المتناقضة، كان لا بد أن يكون له تأثيره على نوعية الشخصيات والأحداث، فقد غدت هذه منمطة ، تعبر عن العام الاجتماعي بدون الخاص الفردي، رغم محاولات المؤلف إعطاء لمحات شخصية متفردة. مثلما فعل تجاه شخصية بدرية التي صارت رمزا كاملاً لا شخصية حية متناقضة. وقد تمثل التنميط في أحداث الرواية، عبر هذا التناقض والصراع بين بؤرتي البنية الفنية، فهناك بؤرة للبناء الروائي، حيث القصة ذات الحدث الروائي غير القصير، المتسع . وهناك بؤرة التصوير التسجيلي والاحتفالي للحي الشعبي، التي حشدت فيها عدة قصص قصيرة .
وليست الرواية الاماراتية بعيدة عن مسار واشكالات الرواية الكويتية. فلقد نمت الرواية الاماراتية بخطى صاعدة ، ولكن محدودة ومتقطعة. فرواية «شاهندة»، المبكرة عكست سمات قديمة في الرواية العربية ككثرة المغامرات والتحولات المفاجئة والانقلابات الحديثة والشخصية، بحيث ان الرواية لم تستطع أن تصور شخصيتها المحورية، بحيث ان الرواية لم تستطع أن تصور شخصيتها المحورية، من جوانب عميقة، ولم تستطع أن تتابع شبكة الشخصيات العديدة التي ظهرت ثم اختفت، عبر تعاريج وتضاريس الأحداث الغريبة الكثيرة. كذلك فإن المكان بدا متغيراً بسرعة الأحداث، حتى اننا لم نلم بمكان ذى حضور روائي هام.
ولهذا فإن القرية البحرية المصورة – جنين المدينة الخليجية المعاصرة – سرعان ما تذوب أجوائها وتختفى شخصيتها، عبر هذا الطيران المتسارع للأحداث، وإذا كان علي محمد راشد يتابع هذه التقنية القديمة في الرواية الاماراتية والعربية، عبر سيطرة الاحداث السياسية العامة المتسارعة، وفي عدم التوغل داخل نسيج الشخصية والمكان والزمان، فإن روائيين إماراتيين آخرين يبدأون بتجاوز هذا المستوى الفنى.
لقد بدا علي ابوالريش قريباً من هذا المستوى في روايته الأولى، لكنه امتاز بخصائص فنية جديدة ملفتة للنظر، فقد تناغم لديه التحليل الاجتماعي والسيكولوجي للشخصية، عبر لغة سردية – حوارية واسعة – ومتخلخلة إلى كميات الشخصية والحدث.
ان «الاعتراف»، ذات النسيج الميلودرامي، والتي تحتوي على العديد من الخصائص رواية المغامرات والأحداث المفاجئة، قد امتلكت كذلك معماراً جيداً، عبر السيطرة على الحدث المركزي الثاني، لا الأول، وترابط الحدث والشخصيات، رغم تناقض بؤرتي الرواية، حيث كانت البؤرة الاولى تتركز حول انتقام صارم، والثانية حول زواجه وحبه وصداقاته، أن عدم السيطرة على هاتين البؤرتين وعدم اندماجهما معا في نسيج واحد متداخل، أدى إلى عدم وجود صراع ملتهب مفجر لنمو الحدث والشخصية.
لكن روايته الثانية شهدت تطوراً هاماً، حيث سيطرت فيها بؤرة واحدة، هي الصراع في ذات سلطان – البطل المحوري، بين البحر والمدينة، بين الأصالة والمعاصرة، بين الشرق والغرب.
لقد صار سلطان هو النموذج المركزي، الذي تدور حوله كافة جزيئات العمل وأحداثه وأمكنته، وعبرٌ هذا النموذج عن صراعات هامة في الحياة، رغم وقوف الشخصية، أيضا، على ضفاف المدينة، فنحن لا نجد إلا الصراع بين العمالة الأجنبية والمدينة العربية الخليجية، وكأن هذه المدينة تفتقد التناقضات الداخلية، التى تسربت منها العمالة الاجنبية.
لكن وجود بؤرة مركزية صراعية متوترة أدى الى تطور اللغة الروائية عند علي أبوالريش وتناغم السرد والوصف والحوار مع الحالات الداخلية للشخصية ومحور الرواية. رغم أن مساحات التشكيل السردية الوصفية – الحوارية تطول احياناً وتتكرر بلا وظيفة فنية.
وهذا ما يشابه في بعض جوانبه اسلوب علي محمد راشد في روايته التاريخية التسجيلية «ساحل الابطال»، التي تركز على عدم تناقضية المدينة الخليجية، ووحدة صفوفها، مما يشكل لوحة رومانسية خيالية، رغم الطابع الوطني والقومي المضيء لهذا التصور.
ان هذا التوجه الروائي، كما في المثالين السابقين، لا يتغلغل في صراعات المدينة الخليجية ذاتها، وهو يضعها دائما في مواجهة التناقض مع الاجانب، سواء كانوا مستعمرين قساة أو عمالاً فقراء.
لكن ثمة توجه آخر، في الرواية الاماراتية، يمثله محمد الحربي في روايته «أحداث مدينة على الشاطىء»، الذي يصور تناقضات المدينة ذاتها. فنحن نجد المدينة هنا كائنا اجتماعيا وتاريخيا ناميا، وليس شكلاً عمرانياً منجزاً ومادياً محضاً. فالروائي هنا يغوص عبر نماذجه الكثيرة، في هذه البلدة البحرية ــ البدوية المتحولة الى تجمع ضخم. وهو يصيغ عبر السرد الواسع هذه الشبكة من الشخصيات والأحداث.
إن بذور مدرسة فنية أولية تتضح من هذا العرض. فاغلب النماذج المدروسة هناك تتجه الى تصوير الواقع ونقده. ان عرض النماذج المأزومة في القصة القصيرة يقود الى البحث عن الشبكة الواسعة لتشكيل البشر . فليلى العثمان في تجربتها الروائية تقوم برصد نماذج مأزومة، في واقع تسيطر عليه تناقضات مجردة: القديم/ الحديث، البحر/ المدينة، التخلف/ التقدم. فعبدالله البحار القديم لا بلدته البحرية الجميلة الإنسانية، فيقرر أن ينتحر متحداً بنموذجه الجمالي القديم، وحبه. ان هذا الانسحاب الاحتجاجي لا يتوغل في تضاريس الواقع المعاصر، ولكنه يمثل ادانة رومانسية عنيفة ضده.
أما وليد الرجيب في «بدرية»، فإنه يتوغل في عروق الحياة، كاشفاً تناقضاتها الداخلية، وطابعها التاريخي المرحلي، وهنا تتضافر روح شعبية ساخرة واحتفالية، مع منهج تحليلي طبقي، يتعاونان في تشكيل رواية أكثر غوصاً في واقعيتها النقدية. ونلحظ عند علي أبوالريش ما نلحظه لدى ليلى العثمان، من تزاوج بين الواقعية والرومانسية، حيث يتجسد تناقض البحر/ المدينة، الماضي/ الحاضر، التراث/ المعاصرة، في ذات الروايتين «وسمية تخرج من البحر»، و«السيف والزهرة». ولكن علي أبوالريش يتوجه بصورة أكبر، لنشر الحياة، لتصوير الواقع بمظاهره البارزة، وكأنه يبدأ مشروعاً كبيراً لقراءة نقدية ودينية للمدينة المعاصرة.
يشابه محمد حسن الحربي وليد الرجيب في الكويت، في بحثه النقدي التاريخي للواقع، وكشفه لصراعاته الممتدة من الماضي الى الحاضر، عبر لغة هادئة وتشكيلية للعالم. وتبدو رؤيته متخلصة من هذا الذوبان في البحر والماضي، ومتجهة بصورة أكبر، لقراءة تأثير البر والبادية على تكوين المدينة، وهو يوسع الطابع البدوي ويقرأه بصورة مترافقة مع التحليل الاجتماعي النقدي للتطور .
ورغم هذا فلا تزال هذه الرواية الخليجية البكر على ضفاف التحليل العميق الموسع للواقع، لم تتغلغل بعد الى الطبقات التحتية الكثيفة له، وخاصة المستويين الروحي والنفسي، ولا تزال تمشي فوق تضاريسه الاقتصادية والاجتماعية المباشرة .
ونظرا لكل ما سبق، فليس لدينا في النماذج المدروسة، تقنيات ابداعية الجديدة. أى مبتكرة، فهي تتركز على الاستخدام الموسع للسرد، الذي يبدو مكثفا وامضا عند ليلى العثمان، واجتماعيا ومعتمدا على تقارير البحث الاجتماعي عند وليد الرجيب، وواسعاً ومندمجاً بوصف وحوار – بلا فواصل – لدى علي ابوالريش، وواسعاً مسيطراً لدى محمد حسن الحربي. وغالباً ما يكون الحوار والوصف في تبعية شبه مطلقة للسرد. كما أن الاستبطان والحوار الداخلي كبير لدى ليلى العثمان وعلى ابوالريش، حيث يغدو داخل الشخصية، أهم بكثير، من الظاهرات الخارجية والرصد الاجتماعي، في حين أن الحوار الداخلي لا يمثل شيئاً مهماً واساسياً في تقنية وليد الرجيب ومحمد الحربي، حيث يتركز البناء على الخارج، والتطور العام. ولم نجد في رواية «بدرية» إلا حواراً داخلياً وامضاً وصغيراً، في حين أن حوار محمد الحربي الداخلي بدأ مفاجئاً ومنقطعاً عن بنية الرواية .
ان رواية الخليج الحديثة ــ المبكرة، تبدأ خطواتها الاولى في فهم الواقع، وتشكيل بنية متضافرة، ولهذا فإنها لا تستطيع ان تسيطر على أدواتها الفنية تماماً، وهي تبدأ بتشكيل مفرداتها الاساسية اولاً كالسرد وتشكيل الشخصية وبناء المحور الواحد الأساسي للرواية، وتبقى مهمات جمالية اجتماعية كبيرة أمامها، للسيطرة على عالمها الفني.
يتبع 2 من 4 ...



