باسم سليمان's Blog, page 18
September 22, 2022
الفداء … مقطع من روايتي جريمة في مسرح القباني 2020 عن دار ميم الجزائر – باسم سليمان
انصرم ثالث أيّام العيد دون نتيجة. نال التعب من المحقّق هشام، وأمسى مرهقاً جداً ،فاستسلم للنعاس، ولم يصحُ إلا في فجر اليوم التالي، آخر أيام العيد. كانت السماء مكفهرّة، وهناك احتمال كبير لهطول المطر. أمضى كامل وقته في مكتبه، لا يستقرّ على هدى! وفي خضم سيلان ذاكرته، وأفكاره وجدله، انبثقت قصّة النبي إبراهيم، كأنّها جذوع أشجار اقتلعها سيل عرمرم، فبدأ بالتمسّك بالجذوع محاولاً الوصول إلى ضفة الطوفان. استذكر الآيات التي تخصّ خليل الله إبراهيم، ومنهجيّة النبيّ في التفكير، فالذي يقول:(لا أحبّ الآفلين ) لا يمكن أن يركن إلى مجرّد حلم يأمره بأن يذبح ابنه الذي كاد ييأس من أن يهبه الله إياه بعدما أصبح شيخاً وامرأته قد فاتها زمن الخصوبة، ولا يعقل أنّ من انتخبه الله خليلاً وأنجاه من النمرود والتحريق بالنار، وكيف يحيي الموتى، أن ينحدر لوثنية سابقة كانت تسمح بتقديم الأطفال كأضاحي!؟
هل شعر النبي إبراهيم المحتاج إلى الله، أنه قصّر وسمح للشيطان أن يدخل إلى نفسه، ويوسوس له كما أغوى أباه آدم من قبل بأن يأكل من الشجرة المحرّمة؟ فالله أمر آدم وزوجته حواء بأن يأكلا من كلّ ثمار الجنّة، وأن يمتنعا عن شجرة مخصوصة أشار الله إليها، وآدم الذي عرف الأسماء كلها وصار سميعاً بصيراً، أدرك أنّه ليس خالداً كالله، أو الملائكة أو حتّى الجان؛ فمصيره الموت بعد الحياة وسيطويه النسيان.
كيف أدرك آدم حتمية الموت، والموت كحادث للمخلوق البشري لم يكن مطروقاً في الجنة!؟ هل علم الغيب وهذا غير ممكن وليس مؤهلاً له!؟ هل سرّب الشيطان من خلال وسوسته له هذه المعلومة، وأقسم له أنه من الناصحين!؟ لربما يصحّ ذلك لكن من أين جاء الشيطان بتلك المعلومة!؟ في عاصفة النقاش الدائر في ذهن المحقّق، طفا موضوع الاصطفاء، فردد الآية في فضاء مكتبه: ( إِنَّ اللَّه اِصْطَفَى آدَم وَنُوحًا وَآل إِبْرَاهِيم وَآل عِمْرَان عَلَى الْعَالَمِينَ ) وكما ردّد الآية، كلّم نفسه: الاصطفاء يكون من مجموع متشابه ومتماثل، كأن تقوم بانتقاء كيلو تفاح من صندوق التفاح عند بائع الفواكه، وهذا يصحّ على نوح وإبراهيم وآل عمران لأمثالهم من البشر، لكن آدم كان بداية الخلق، فليس من أحد غيره كما تقول التفاسير. يبدو الأمر على غير ذلك، وما إشارة ( مواراة السوءات ) التي خضع آدم لها إلا دلالة على عدم تعلّق معنى السوءات بالعورات، فالعورة واضحة المعنى ودلالتها الفروج التي يجب سترها أمّا السوءات، فكثيرة، ومواراتها تعني إخفاءها تحت طبقات من التحسين والإصلاح. لنفترض أن آدم لم يكن أول البشر بل كان هناك مجموعة بشرية تعيش على الأرض ومنها تم انتقاء آدم ومن ثم تهذيبه عبر مواراة السوءات، وتحضيره كخليفة وما إن تنتهي حضانته في الجنة وتأهيله، يعاد إلى الأرض كي يعمّرها، وهذا يقود إلى السبب في عداوة الشيطان له، فالشيطان على ما يظهر كان وكيلاً للسماء في مرحلة الأرض التي كانت فيها تلتهب وبعد أن بردت وصارت جاهزة لقدوم المخلوق البشريّ، الذي سيصبح وكيلاً للسماء على الأرض، غدا حكم الشيطان مهدّداً، وما تأفّف الملائكة من كلام الله بأنّه سيجعل في الأرض خليفة إلّا بسبب مقارنتهم بين المخلوق البشري الذي يملأ الأرض، ويسفك الدماء وآدم الذي سيكون خليفة، فالملائكة لا تعلم الغيب، لكنها رأت ما يفعله المخلوق البشري! وعندما بررت اعتراضها قالت (أتجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء ) فهي تتكلّم عن حال قائمة الآن بدليل الفعل المضارع والاسم الموصول ( من ) الذي يشير إلى الكائن العاقل البشري.
ومن هنا تصبح مواراة السوءات، تعني تعديل آدم ونقله من مرحلة البشري إلى مرحلة الإنساني، لكنّ استعجال آدم الخلافة وإدراكه أنّه سيموت كأمثاله من الكائنات البشرية الموجودة على الأرض دفعه إلى ممارسة الجنس كي ينجب وريثه، فشجرة الخلد والملك الذي لا يبلى تفترض ذلك، فهل واقع حواء أم أنثى أخرى؟ يبدو أن أنثى أخرى كانت أمّاً لقابيل، فالنص الديني يخصّ آدم لوحده بالغواية والعصيان ويسكت عن حواء.
تأمل فيما تداعى إلى ذهنه من أفكار، ولمعت جملة تخصّ هابيل ابن النبي آدم، وتتعلّق بالإثم الذي تكلّم عنه هابيل قائلاً: (إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّار، وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ) مضيفاً للكلمة ( إثم) ياء المتكلّم، التي تعني أيضاً الملكية، فما هو إثم هابيل؟ يرفض هابيل أن يمدّ يده بسوء إلى أخيه قابيل، فيما قابيل لا يرتدع، فهو يريد الخلود والبقاء كما أبيه آدم قبل التوبة لذلك يقتل هابيل. هابيل كان واعياً للغواية، والخطيئة الأساسيّة، وأنّها تجري في عروقه مجرى الدم وراثة عن أبيه وإلا لِم كان التحذير من الله إلى أبناء آدم بأن يحذروا غواية الشيطان، فلا يغويهم كما أخرج أبويهم من الجنة بالإضافة إلى قول هابيل: (بِإِثْمِي).
أضاءت له الجملة تساؤلاته عن رؤيا إبراهيم، الذي أدرك أنّه قد وقع في شرك شبيه بالذي وقع فيه أبوه آدم، فطلب أن يكون له ذرّية وخاصة أنّه قد كبر في العمر، وأصبح شيخاً وامرأته غادرتها عادة النساء، وإن استجابة الله له ما هي إلا مكر كي يختبره، بعد أن علّمه أن يطمئن قلبه ولا يجزع من الموت سواء بإحياء الطيور التي شدّها إلى يده أو نجاته من نار نمرود، فلو كان الله يريد أن تكون له ذرّية لوهبه ذلك دون أن يسأل، فالله أعلم بما في الصدور، ومن هنا كانت رؤياه في المنام تعبيراً عن مكبوتاته التي يعمل عقله الواعي على حجبها، فجاءته في الحلم، وما ردّ ابنه بقوله ( افعل ما تؤمر ) جاعلاً الفعل مبنياً للمجهول إلّا لإدراك الابن هواجس والده، فالولد سرّ أبيه، فلقد أكمل جوابه ) إن شاء الله ستجدني من الصابرين ( وما جوابه إلّا تسليم مطلق لله، فيأتي تدخل الله بفداء ابن ابراهيم بالكبش منهياً الخطيئة الأصلية، بعدما استفاق ابراهيم من غفلته، ورفض الخلود إلى الأرض كما فعل أبوه آدم وكان ابنه كما هابيل موقناً ورافضاً للغواية التي وقع فيها قابيل. هكذا انتهى الإرث وأصبح إبراهيم آدم المثال كما قدر له قبل الغواية، فللبشرية تاريخان، واحد يبدأ من آدم وينتهي مع إبراهيم، وثان يبدأ من إبراهيم مستمراً إلى الآن، نستطيع فيه أن نجبّ الجريمة عبر العقوبة أو الفداء.
أتكون هذه النتيجة، هي الأصل المخفي لنظرية التصعيد التي تكلّم عنها سيغموند فرويد بأن الكبت يتحوّل، وقد ينتهي إلى فنّ وجمال وإبداع!؟
والآن هل حارس المسرح، ومحرّك الدمى أحد الأشباه لقصتي آدم وإبراهيم؟
ــــــــــــــــــــ
مقطع من روايتي: جريمة في مسرح القباني الصادرة عن دار ميم 2020

قريبًا عن دار سين .. دمشق … الحب عزاؤنا الأخير
September 2, 2022
بنات آدم – مقالي في رصيف22 – باسم سليمان
الجمعة 2 سبتمبر 202204:13 م
يمكن اعتبار عائلة “آدم وحواء” العائلة الذهبية في تاريخ البشرية. ففي القصص الديني، “تحدّرنا” جميعاً منها. لقد حملنا جيناتهم وطبائعهم، فالخطيئة والغفران ورثناهما من الوالدين، آدم وحواء، والقوة والبأس والكره من قابيل، والطيبة والمحبة والإيمان من شيث، الذي يعني هبة الله. شغفنا بمعرفةِ أصلنا الذي جئنا منه لم تروه الكتب السماوية، لذلك كان لا بدّ لنا أن نخترع حكايتنا الخاصة عنهم، مالئيها بالتفاصيل والأسئلة والأجوبة عمّا أغفلته السردية الرسمية للكتب السماوية، فكانت حكايتنا الخاصة عن العائلة الذهبية سبباً في توسعة أرضنا وفتح آفاقنا أكثر.
قدّمت التوراة معلومات لابأس بها عن العائلة البشرية الأولى، فقد أوردت أسماء أبناء آدم وحواء الذكور. قابيل الذي قالت عنه حواء، كما جاء في التوراة: “اقتنيت رجلاً من عند الرب”، ومن ثم تذكر التوراة بأنّ حواء أنجبت هابيل، وتخصّص بعد ذلك عمل كلٍّ من الولدين، ليكون قابيل زارع حبوب، وهابيل راعي ماشية، وأنجبت حواء شيث بعد مقتل هابيل، لكنّ التوراة أغفلت ذكر البنات.
الأسرة الأولى في القرآنلم يتطرّق القرآن إلى ذكر البنية الكاملة لأسرة آدم وحواء، واكتفى بذكر قابيل وهابيل بالأسماء، وأورد أنّ السماء قبلت قربان أحدهما وأشاحت النظر عن قربان الآخر: “وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَاناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ”.
هذه الآية تتكلم عن ولدين فقط لا ثالث لهما، وقد افترض التراث الإسلامي بأنّهما قابيل وهابيل استناداً إلى الأحاديث ورواية التوراة. أمّا شيث الولد الثالث، فليس هناك إشارة تدل على وجوده في القرآن، بل اقتصر ذكره على الأحاديث النبوية، فقد قال النبي: أُنزِل على شِيثَ خمسونَ صحيفةً”، وفق ما ورد في كتاب “صحيح” ابن حبان. وعلى صعيد النساء، فلم يأت ذكر أيّ خبر عن امرأة تعود إلى أسرة آدم وحواء، أكانت ابنةً أو زوجة لأحد أبنائهما.
تتكرّر حكاية القربان في التوراة كما في القرآن، ولكن مع تفصيل أكثر، وذلك بأنّ هابيل قدّم من أبكار غنمه وسمانها، في حين قدّم قابيل من ثمار الأرض. لقد نظرت السماء إلى قربان هابيل وأشاحت النظر عن قربان قابيل، ولا ريب أنّ جملة “من أبكار غنمه ومن سمانها”، المضافة إلى تقدمة هابيل، في حين ذكرت بشكل عام تقدمة قابيل بجملة “من أثمار الأرض”، تشير بطريقة ما إلى أن أيّ من القربانين سيقبل. وترتب على ذلك بأنّ قابيل قتل أخاه هابيل.
تتابع التوراة سرد الأحداث العاصفة التي مرّت بعائلة آدم، فبعد الجريمة التي ارتكبها قابيل، تزوج امرأة ما وأنجبا حنوك، وبعد ذلك تشجرت عائلة قابيل فأصبحت نسلاً كثيراً.
تستمر التوراة في التأسيس للعائلة البشرية الأولى، وتتكلّم عن شيث الذي كان عوضاً عن هابيل: “إنّ الله قد وضع لي نسلاً آخر عوضاً عن هابيل”، كذلك يعرف شيث امرأته التي أنجبت ولداً اسمه أنوش.
هاتان هما الروايتان الرسميتان لأولاد آدم وحواء، وعلى الرغم من أنّهما عرضا لنا الإبرة/العبرة وأسقطا كومة القش من السردية، إلّا أنّ الأسئلة التي نتجت عنهما كان لا بد منها، لأنّ عائلة آدم وحواء هي النواة الأساسية للبشرية الوحيدة التي لم يكن غيرها على الأرض، وفق الإخبار الإلهي. وعليه، كان السؤال: كيف تكاثرت؟ فإن كانت حواء قد خلقت من نفس آدم/ضلعه، فقابيل وهابيل وشيث لم تكن لهم نساء يعرفنهم كما حدث مع أبيهم آدم.
هذا السؤال استدعى سردية أخرى رتبها العقل البشري وفق مقتضى الحال، بأن افترض ولادة توأم أنثى مع كل بطن من بطون حواء، أي أنّ قابيل جاءت معه توأم أنثى، وكذلك هابيل، أمّا شيث فكان مقتل هابيل دلالة على ولادته لوحده من دون توأم، فأخت هابيل ستكون توأماً افتراضيّاً له، هذا في الرواية التوراتية، ولكن في إحدى الروايات الإسلامية يختلف شيث عن أخويه السابقين فلم تولد معه توأمة.
قد نتنبه أن افتراض التوأمة كحل لإيجاد بنات يشي بمطابقة بين تخليق حواء من نفس/ضلع آدم، فالتوأمة هي بيضة قد انقسمت وأنتجت جنينين، كما انقسم آدم عن نفسه، وخُلقت منه حواء، سواء كانت النفس التي خلق منها زوجها كما في القرآن، أو الضلع كما في التوراة، أو بقية الطين الذي زاد عن خلقة آدم، فخلقت منه حواء.
بعد أن بسطنا الأرضية التأصيلية للعائلة البشرية الأولى، فلنتعرف على بنات هذه العائلة وسرديتهن المغفلة من المدونة الرسمية، والتي تصدت للبوح بها المدونة الشعبية إن صحّ القول.
الابنة الكبرىهي شقيقة قابيل التوأم. وقابيل يعني الكاره، لأنّه كان يبغض أخته وهي معه في الرحم، لذلك سمّاه آدم “قابيل”، وكُرهه سينقلب لاحقاً عشقاً وولهاً. أما الطفلة، فتدعى لولوا Luluwa أي الجميلة، لأنها كانت أجمل من أمها حواء، وفق ما ذكر في كتاب “بنات آدم وحواء” الذي يعود إلى سنة 494. إلّا أنّ لهذه الفتاة أسماء كثيرة تعدّدت وفق تعدد المصادر: أقليما، كالمانا، كاينان، آزورا. أقليما، هي تسمية المصادر العربية وفق أبي إسحاق الثعلبي في كتابه “الكشف والبيان في تفسير القرآن” (1425هـ)، وفي مصادر إسلامية أخرى كانت أخت قابيل هي لوسيا، وأخت هابيل هي أقليما.
ومن أسمائها الأخرى: “كالمانا”، و”آزورا” أو “عوان” و”لوزيا”، فتعددت هذه الأسماء حسب المصادر، لكن القاسم المشترك بينها، أنّها كانت توأمة قابيل، وأنّها أجمل من توأمة هابيل، ومن أجلها قَتل قابيل أخاه.
أيّاً يكن فإن أقليما المكروهة من أخيها في بطن حواء كانت جميلة وكان يجب أن تكون من نصيب هابيل، وتوأمة هابيل من نصيب قابيل، لكن هذا التقسيم الذي أوجده آدم كيلا يزوّج التوائم من ذات البطن من بعضها بعضاً لم يُرض قابيل. فاقترح آدم أن يقدّم كلٌّ منهما قرباناً، ويترك الحكم للسماء.
تختلف القصة عن التوراة لجهة نوعية التقدمات، فقابيل يقدم من غنمه وهابيل من قمحه. أمّا لجهة تدخل الشيطان بالوسوسة لقابيل كي يقتل أخاه، ففي كتاب “بنات آدم وحواء” توسعة كبيرة لهذه الوسوسة، وكلها تتعلّق بـ”لولوا” الجميلة التي ولّهت قلب قابيل، حتى أنّه عنف أمه بسبب أنّها وأباه يريدان تزويجها لهابيل. بعد واقعة التقدمات القربانية وتقبل السماء من هابيل، يقتل قابيل أخاه ويتزوج أخته لولوا/ أقليما غصباً، ويقيم منها نسلاً.
ربما فكّر قابيل بأنّه ولولوا تكوّنا بعد خطيئة أبويهما الجنسية في السماء، وأنّ أخت هابيل أرضية، وهذا لا يناسب المكانة التي اعتقدها بنفسه عن أصوله السماوية وأصول هابيل الأرضية.
توأمة هابيل الحزينةتدعى توأمةُ هابيل “أكليا”، وفق كتاب “بنات آدم وحواء”، وكتاب “صراع آدم وحواء”، وكتاب “كهف الكنوز”، وكان من المفترض أن تكون زوجة لقابيل، لكن بعد مقتل هابيل وزواج قابيل من لولوا تنتظر حتى ولادة شيث، فتصبح زوجة له.
وقد ذُكر في مصادر أخرى أنّ آدم وحواء أنجبا أولاداً آخرين، لكنّ أسماءهم ظلت مغفلة، أمّا الذين ذُكروا منهم فقد كانوا خمسة، كما جاء في كتاب “صراع آدم وحواء مع الشيطان“: قابيل، ولولوا، وهابيل، وأكليا، وشيث.
الأمانةلا تفترق الرواية الإسلامية كثيراً عن الرواية اليهودية والمسيحية في ذكر أولاد آدم وبناته، وهذه الروايات اتفقت على أسماء الذكور، واختلفت على أسماء الإناث، فكما جاء في “أخبار الزمان” للمسعودي، قليما هي أخت قابيل من ذات البطن، وليوذا هي أخت هابيل من ذات البطن. ويذكر المسعودي بأنّ قابيل رغب بأخته قليما لأنّها أجمل من ليوذا، ولم يكن من حلّ إلّا من خلال تقدمة القرابين.
وجاءت النتيجة بأنّ قبلت السماء قربانَ هابيل ورفضت قربان قابيل، فحقد على أخيه هابيل وأراد قتله. وعندما أراد آدم زيارةَ البيت العتيق في مكة طلب من السماوات والجبال أن تحفظ ابنه، فرفضت، وتصدى قابيل لذلك، وقال: نعم ترجع وترى ولدَك كما يسرّك. فرجع آدم ووجد أن قابيل قد قتل أخاه، وفي ذلك قول القرآن: “إِنَّا عَرَضْنَا ٱلأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَاوَات وَٱلأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلإِنْسَانُ”، وفق ما أورده الثعلبي في كتابه “الكشف والبيان”. يتابع المسعودي ذكر أولاد آدم، فيذكر ولادة شيث وتوأمته، وعلى ما يبدو أنّه قد تزوجها، وقد سكت عن ذلك المسعودي.
إشكالية التحريم، أي زواج الإخوة بالأخوات، قد تمت معالجتها في السرديات شبه الرسمية في اليهودية والمسيحية والإسلام، وذلك بأن يزوج كلُّ ذكر بتوأمة أخيه الذكر الآخر. ولربما يعود هذا الحلّ الذي افترض ولادة توأم أنثى مع كلّ ذكر من أولاد آدم إلى أنّ تحريم الزواج بالأخت الذي نُصّ عليه لاحقاً سيكون نافذاً بأقل الاعتراضات، حيث سيقال بأنّ زواج ابنتي آدم وحواء من أخويهما كان استثناء.
هذا الافتراض الذي أوردناه أعلاه لم يكن مطروحاً بالنسبة إلى إحدى السرديات الإسلامية، فقد نقل عن الإمام جعفر الصادق كما جاء في كتاب “بحار الأنوار”، بأنّه قد تمّ تزويج قابيل من جنية تدعى “جهانة”. أمّا هابيل فزُوّج بحورية من الجنة اسمها “نزل الحوراء”. وقد ترتب على ذلك بأنّ الجمال والخلق الحسن جاءنا من الحوراء، أما سوء الطبع فجاءنا من الجنية. وبعد مقتل هابيل جزع آدم، ولم يقرب حواء مدّة طويلة حتى قيض الله له ذلك، فأولدها شيث الذي زوجه من حوراء في الجنة اسمها “نزلة”، ومن بعد شيث أولدها يافث، فزوجه أيضاً بحوراء من الجنة اسمها “منزلة”. وهكذا حُلّت قضية تحريم الزواج بالأخوات في الأسرة الأولى للبشرية.
“عناق”، والدة العملاق “عوج”يذكر المسعودي في كتابه “أخبار الزمان” بأنّ “عناق” ابنة آدم وحواء ولدت مفردة بلا أخ، وأنّها كانت غريبة الخلق، لها رأسان، وكان لها في كل يد عشر أصابع، وفي كل اصبع ظفران كالمناجل. وقد ذكر بأنّ الإمام علي قال عنها بأنّها أول من زنى على الأرض، وجاهرت بالمعاصي واستخدام الشياطين. أمّا كيف ترتبت لها القدرة على تسخير الشيطان، فذلك لأنّ الله أنزل على آدم أسماء تطيعها الشياطين، فعلّقتها حواء على نفسها، فكانت حرزاً لها من الشياطين، إلّا أن عناق قامت بسرقتها، وعملت السّحر، وأضلت الكثير من ولد آدم، وأنجبت العملاق “عوج” الذي نجا من الطوفان، وقتله النبي موسى. هذه الأفعال الشنيعة دفعت آدم لأن يدعو عليها، فأرسل الله إليها أسداً كالفيل افترسها.
تعددت المصادر غير الرسمية التي تذكر بنات العائلة البشرية الأولى، فقد جاء ذكرهن في “كتاب بنات آدم” (سنة 494)، وقد أراد البابا جيلاسيوس إدراج هذا الكتاب في المدونة الرسمية، لكن الكنيسة لم توافق. هذا يعني أن الكتاب كان معروفاً قبل ذلك، وهناك كتب كثيرة غيره تناولت سيرة العائلة البشرية الأولى كما هو وارد في كتاب “الوجوه المتعددة للمسيح: قصة الألف عام لبقاء وتأثير الأناجيل المفقودة” (2015)، وكما جاء في كتاب “اليوبيلات اليهودي”، وكتاب “صراع آدم وحواء مع الشيطان“، الذي يعود للقرن السادس، وكتاب “كهف الكنوز” للقديس كليمنت.
تواجد هذه الكتب دلالة رغبة حاسمة من قبل البشرية في معرفة أصولها التي تتحدّر منها، حتى لو خرجت عن الرواية الرسمية للأديان. هذا الأمر أغنى التجربة البشرية ومنحها الحق بأن تكون لها روايتها الخاصة، سواءً وافقت الكتب السماوية أم خالفتها، فذلك يعني أن الإنسان هو الخليفة لهذه الأرض، وله القدرة أن يسوسها ويشرع في عمارتها.
https://raseef22.net/article/1088677-%D8%A8%D9%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%AF%D9 https://raseef22.net/article/1088677-%D8%A8%D9%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%AF%D9

الذئب النباتي – قصتي في القبس الكويتية – باسم سليمان
كان صوت الأرنب، يتردّد في أجواء الغابة، قافزًا هنا وهناك، حاملًا خبر الجرائد الأول: الغزالة السمراء ضحيّة جديدة للغول. الغزالة السمراء ضحية جديدة للغول. تهافتت الحيوانات تبتاع الجرائد من الأرنب، كي تعرف تفاصيل الجريمة، مع أنّه في الصفحات الداخلية للجرائد كان هناك إعلان هام جدًا، بأنّ اليوم، السادس عشر من السنة الألف للغابة، ستجري محاكمة الذئب، وقد تكون أهم محاكمة في هذه الألفية. ليس بعيدًا عن جمهور الحيوانات الذي التف حول الأرنب، كانت محاكمة الذئب قد انعقدت برئاسة النسر آكل الجيف، أسفل شجرة السنديان العظيمة، أقدم شجرة في الغابة من يوم وجدت. بدأت المحاكمة بعد أن صرخ الهدهد: محكمة! النسر آكل الجيف: أيّها الذئب، أنت متهمٌ من قبل الخراف، بأنّك أفسدت الحملان بآرائك. بينما يوّجه إليك كلب الراعي تهمةَ التسبّب في فقدانه لعمله. الذئب: حضرة القاضي، كيف لقراري، بأن أصبح ذئبًا نباتيًّا، أن يكون جرمًا! يا للعجب، فلتخوّف الخرافُ الحملان بالنمر! أمّا كلب الراعي، فهو لا يحرس القطيع منّي فقط، بل يحرسه من مفترسات أخرى. نبح كلب الراعي: لكنّني فقدت عملي، بعد أن سمع الراعي، بأنّك أصبحت نباتيًّا، فليس من حاجة إلى كلب يحرس القطيع من الذئب. أردفت الخراف: وحملاننا، خرجت عن رأينا، فما من شيء يردعها، فهي تهزأ بنا، وتطلب منّا، تخويفها بالغول عندما نهددها بالعقاب على أفعالها المشينة.
الذئب: ما تقولونه هراء ولوي لأعناق الحقائق.
الكلب: أنت من تسبّب بهذه النتائج، لا أحد غيرك.
الخراف: كلام كلب الراعي، صحيح.
الذئب: هذا افتراء صريح.
القاضي: هدوء في قاعة المحكمة وإن لن تصمتوا سأسجنكم جميعًا. التزم المتخاصمون الصمت وعيونهم على شفاه القاضي. القاضي: إنّ الذئب لم يرتكب جرمًا، فقوانين الغابة لم تنصّ على معاقبة من يغيّر عادات طعامه، وإن كان من بدّ في ذلك، فلنعاقب الخراف لأنّها تأكل الخبز الذي يقدّمه لها الراعي بالإضافة إلى العشب. وأنت أيها الكلب المعروف عنك أنّك تلتهم الطعام المعلّب بشراهة، فلماذا تسكت المحكمة عن تغيير عادات طعامكم، فيما يجب عليها أن تعاقب الذئب؟ إنّ المحكمة هي عين العدالة التي ترى كل شيء، لذلك لا بدّ من أن تحكم ببراءة الذئب، وإلّا سأسجنكم جميعًا لمخالفة عادات طعامكم، وهذا لا يصحّ أبدًا، لذلك قرّرت المحكمة: البراءة الكاملة للذئب من التهم التي وجّهت له من كلب الراعي والخراف. وعليه نقرّر، نحن النسر آكل الجيف بالسلطات التي منحت لنا من الغابة العظيمة ممثلة بحيواناتها، ببراءة الذئب من التهم الموجهة إليه. صدر هذا الحكم باسم جذوع الغابة العظيمة وأفهم علنًا.
الهدهد: محكمة. الذئب: يحيا العدل. الخراف وكلب الراعي: هذا ظلم! القاضي: فليزم الجيمع الهدوء في المحكمة.
كشّر الذئب مبتسمًا للصحافيين الذين تكاثرت أسئلتهم، وعوى: أعلموا الحاضر والغائب، بأنّني أول ذئب نباتي في غابات وسهول الكرة الأرضية، هجر اللحم والتزم الأعشاب، ومن ثمّ شقّ طريقه مبتعدًا من دون الإجابة عن أي سؤال. توجّه الذئب إلى المراعي، وما إن وصل، حتى بدأ بقضم الأعشاب الغضّة، فقد كانت معدته تقرقر من الجوع.
نعق الغراب: مرحبًا أيّها الصياد القديم. أجابه الذئب: لن أتشاءم منك، وأرتد عن قراري، لأنّك نعقت من الجانب الأيسر، فأنا مصرٌّ عليه، لكن أهلًا بك، أيّها الصاحب القديم. الغراب: ما أقدمت عليه، سيسجله التاريخ بأحرف من ذهب، ومع ذلك أعذرني، فلو كنت القاضي لحكمت بتجريمك، لما سبّبته من ضرر.
الذئب: أنت وأنا، كنّا شركاء في الصيد، فأنت الأعلم بتأنيب الضمير الذي كان يعتريني بعد كلّ افتراس أقوم به، فلماذا تُنكر عليّ ذلك؟
الغراب: كلا، لا أنكر عليك ما قلته عن تأنيب الضمير، وأنّك تتمنّى أن تكون أصمَ، كي لا تسمع أنين الفرائس، لكن ما أتكلّم عنه، هو خطأ القاضي القانوني، فأنت خالفت تقاليد القصّ التي تنصّ على أنّ الذئب من يفترس الخراف ويخيف الحملان، وكلب الراعي يحرس القطيع من الذئب. ولقد بُنيت دعواهم ضدّك على هذا الأساس. وما تحوّلك إلى ذئب نباتي إلّا اعتداء على تقليد القصّ. وبالتالي اعتداء على الخراف وكلب الراعي.
الذئب: غريب أمرك أيّها الغراب! منذ عرفتك، وأنت شكّاء من تقاليد القصّ التي جعلتك طائرًا للشؤم. ومن ثمّ تدينني، لأنّني أريد التحرّر من أعراف بائدة وتقاليد متخلّفة.
الغراب: الحقّ ما تقول، مازلت أكره هذا التفصيل المتعلّق بالتشاؤم، لكن قبلت ذلك، إكرامًا للحقيقة، لكن ما قولك بالمفترِس الجديد في الغابة، أقصد الغول؟ وهل تصدّق أنّ الغيلان موجودة؟
الذئب: لقد كنت تخبرني عن تقاليد القصّ، والغول قد أصبح قصّة على ألسنة حيوانات الغابة، فلماذا لا أصدّق ذلك؟!
الغراب: هناك فرق، إنّ شخصية الغول ترجع في أصولها إلى الخرافة التي اُسقطت من مصادر دستور الغابة، لأنّها غير حقيقية، فلم يُر غول واحد، خلال ألف سنة من عمر الغابة، أمّا الذئب والخراف وكلب الراعي، فقد كانوا موجودين منذ نبتت أوّل شجرة في الغابة، لذلك قصصهم كالقوانين التي تحكم الغابة.
الذئب: الوقائع أقوى من تلك الأعراف القصصية التي تتكلّم عنها، فالغول قد افترس العديد من الحيوانات.
الغراب: لقد ظهر الغول، منذ بدأت تفكّر بالتحوّل من آكل للحم إلى آكل للعشب.
الذئب: ما الذي تقصده؟
الغراب: أرى أنّ غراب شعرك قد طار، وأصبحت عجوزًا، فلن تستطيع العدو كما كنت في شبابك. ومع خدعتك الذكية كذئب نباتي، ستتطمئن إليك الأجيال الشابة من الطرائد، وتصطادها من دون مطاردة ماراثونية.
الذئب: اغربْ عنّي. ستثبت لك الأيام، بأنّني أصبحت ذئبًا نباتيًّا. طار الغراب من الجانب الأيمن للذئب، ونعق لمرة واحدة، وحلّق بعيدًا. مضت عدّة أشهر، ومن ثمّ في إحدى الصباحات، كان الأرنب يملأ أجواء الغابة بصوته: مات الذئب النباتي، لقد مات الذئب النباتي، وقد قال الطبيب الشرعي، بأنّ سبب الوفاة احتشاء معوي نتيجة لتناوله العشب. صمت الأرنب للحظة، وفكّر بأنّ الغول لم يعد خبر الجرائد الأول، على الرغم من تكاثر جرائمه، ومن ثمّ تابع صراخه على بضاعته من الجرائد: لقد مات الذئب النباتي.

https://alqabas.com/article/5890195-%D8%A7%D9%D8%B0%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%D9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A
September 1, 2022
عن سرديات الرائحة وحاسة الشم.. منذ أفلاطون إلى يومنا
باسم سليمان 1 سبتمبر 2022 مقالي في ضفة ثالثة
قد يكون تاريخ الرائحة صراعًا ما بين حاسة الشّم من جهة، والعين والسمع من جهة أخرى، وذلك من خلال تجلّيهما السوسيولوجي، حيث يرتبط الشّم بالجسد، والسمع والبصر بالعقل. لقد عدّ أفلاطون السمع والبصر الحاستين الشريفتين، فالموسيقى متعلّقة بالسمع، والهندسة مرتبطة بالبصر، وكلاهما من نتاج العقل. تعود إلى أفلاطون قوننة هذه الأفضلية للحواس، دافعًا بحاسة الشّم إلى أسفل الترتيب، معتبرًا إياها ممثلة للجسد سجّان الروح التائقة إلى عالم المُثل، ومهاجمًا الرائحة، إذ عدّها أحد أسباب التلاعب بالعواطف والقرارات العقلية، مستندًا إلى أنّ العاهرات هنّ من يتعطّرن، لذلك على الإنسان الفاضل أن يهتم بالحواس الشريفة التي تغني عقله ويعفّ عن تلك التي تثير الانفعالات والعاطفة والتي تشوش الصفاء العقلي. هذه الفكرة عن دور الرائحة عاطفيّا صحيحة نسبيّا من وجهة نظر العلم(1) وقد أشار إلى ذلك ألدوس هسكلي، بأنّ الروائح سيكون لها في المستقبل الديستوبي للإنسان دور في التحكّم في عواطف الكائنات البشرية وسلوكياتها(2). لا ريب أنّ أفلاطون لم يجد حلّا للاستعصاء المفاهيمي لحاسة الشّم/ الرائحة، فهي ذات طبيعة كيميائية تحليلية، ومنحى فرداني حميمي وغامض، أسواء صدرت من جسد الإنسان، أو غيره من الكائنات والموجودات. يقيم كل من ماكس هوركهايمر وتيودورأودورنو تفريقًا بين الرؤية والشّم، ففي الأولى يبقى المرء نفسه، وفي الثانية فإنّه يتحلّل. وأكثر من عّبر عن هذا التحليل كان باتريك زوسكند في روايته العطر! هل هذه النقطة هي ما أرعبت صاحب المُثل؟ فرأى في الرائحة ما يجعلها تنبو عن الأمثلة التي يسمح بها كل من السمع والبصر، لذلك استبعدها. لم يتخلّف الفلاسفة عن تبنّي تلك النظرة من بعده، فقد أهملوا حاسة الشّم وإن ذكروها، فكان ذلك للإدانة فقط، كما فعل كانط. إنّ الرائحة لم تكن كما نعرفها اليوم، فقد كانت في شقّها الأكبر معبّرة عن النتانة ومسبّبة للأمراض، أكانت صادرة عن الكائن البشري، أو غيره من الكائنات والموجودات، فكان لا بدّ من مجابهة هذا الأمر بشقّها المتبقي عبر التطهّر الجسدي وذلك بإلغائها، أو بإخفائها عبر استخدام العطور الثمينة والبخور في المعابد والطقوس الدينية. لقد لعبت النظافة وأدواتها دورًا مهمًا في تاريخ الرائحة، إلى جانب صناعة العطور التي تجاوزت منذ اللحظة التي استخلص فيه ابن سينا روائح الزهور، تاريخها المرتبط بالروائح المنتجة من الحيوانات، كالمسك وطيب الزبّاد والعنبر، والتي كان يعتقد أنّها تحيل إلى الرغبة الجنسية وما يتعلّق بها من محظورات وسرّية، فليس غريبًا أن نجد أميل زولا ينخرط في ربط العطور الحيوانية بالرغبة الجنسية: “لقد أسلمت نفسها للملذّات المحرّمة مستعينة بذلك بقطعة من المسك”؛ هكذا أدّت النظافة والروائح المنتجة من الزهور والنباتات إلى تبديل النظرة نحو الرائحة. هذا المنحى التصاعدي الإيجابي في فهم الرائحة دُعم بشكل جذري، عندما فكّ الارتباط بين الروائح البشعة والأمراض، التي كان منشؤها نظرية الكيوف الطبيعية، والتي طورها أرسطو حيث كانت ترى في اعتدال المناخ وطيب الهواء من أسباب الصحة، وعلى العكس من ذلك كانت ترى في تطرّف المناخ وسوء الهواء أحد المسبّبات المهمة للأمراض. ولأجل أن نفهم هذه المفارقة لنتذكر بأنّ الملاريا تعني الهواء الفاسد. كان المذهب التجريبي الإنكليزي في العلم مساعدًا في إعادة النظر إلى أهمية حاسة الشّم، وخاصة مع الكشوف الطبية حيث حُلّ الارتباط النظري المحتوم ما بين الرائحة البشعة والأمراض والجراثيم عام 1880. لم تبدأ بشائر إعادة الاعتبار للرائحة إلّا مع التنوير الأوروبي، حيث بدأت الأصوات تنادي بأهمية العواطف والحدس في المعرفة، كما فعل روسو وغوتة، وانضمّ إلى هذا الحلف الرومنسيون الذين شنّوا حملة شعواء على العقل وحواسه الشريفة؛ السمع والبصر، مؤكّدين من جديد على أهمية الجسد وشواغله من لمس، وشمّ، وذائقة. لم يبتعد التحليل النفسي في بداياته عن النظرة التحقيرية للرائحة، فقد ربطها بالدوافع الدنيا للإنسان من ناحية، ومن ناحية أخرى استند التعليل الفرويدي(3) على الداروينية بأنّ تراجع دور حاسة الشّم يعود إلى انتصاب الكائن البشري، حيث سادت حاستي السمع والبصر على غيرها من الحواس، بموجب الشكل الرأسي الذي أخذه الإنسان، مخلفًا وراءه عالم الكائنات الأفقية التي تدب على أربع، فالرائحة إرث بغيض قد ورثناه من أسلافنا الحيوانات.
تدخّلت الديانات السماوية في تاريخ الرائحة، ودعت إلى الطهارة الجسدية التي تزيل روائح الجسد مع ضبط استخدام الرائحة الجندري، فقد سمح للرجل بأن يكون استخدامه للعطر فواحًا في حين حرِّم على المرأة أن يتجاوز شذى عطرها غرفة النوم. هذا لجهة الروائح الطيبة، أمّا النتنة، فالإقصاء واجب ديني. ولكي نفهم خطورة المنظور الذي كانت ترى به الروائح ما علينا إلّا التأمّل في أسباب اختراع السماعة الطبية، الذي لم يكن بداية من أجل سماع أصوات الجسد الداخلية، بل لإبعاد الطبيب عن روائح جسد المريض، وذلك لأنّ المعتقدات الطبية وحتى وقت قريب كانت تعدّ الرائحة وسيلة لانتقال الأمراض، فليس قناع الغراب المحشو منقاره بالأعشاب ذات الرائحة الطيبة إلّا خطّ دفاع أول في مواجهة الطاعون.
لم تتحرّر الرائحة على الرغم من كل ذلك، فقد كانت المفاهيم المبخسة لها ولحاسة الشّم تطاردهما، وكان علينا أن ننتظر المذاهب الحداثية والمابعد حداثية في القرن العشرين حتى يعاد تقييم الرائحة كشاغل وجودي مهمّ وفعّال في حياة الإنسان، وإن كان في جانبه الأكبر غير مدرك بشكل مباشر.
إنّ تاريخ الرائحة خليط من الخرافات، والمعتقدات الفلسفية، والعلمية، والأحكام الأخلاقية، فنجد سقراط يذهب إلى أنّ الرائحة تحدّد الانتماءات الاجتماعية والطبقية مضافًا إليها العنصرية. أورد دافيد لو بروتون في كتابه(4) فصلًا عن الرائحة، ناقش فيه التصورات العنصرية المستمدّة من رائحة أجساد شعب ما أو فئة من الناس، فقد وصِف العرب واليهود، بأنّ لهم رائحة الجيف، والسود بالنتانة. وقد ذكر الطيارون الذين حلّقوا فوق المدن الألمانية الرائحة البشعة التي تنبعث من تلك المدن والتي نعتوها بالرائحة الحيوانية. في حين وصف الياباني الإنسان الغربي، بأنّ له رائحة الجبن النتن.
تعتبر حاسة الشّم من المنظور التطوري من الأجزاء القديمة للدماغ، وهي على علاقة غير مباشرة مع اللحاء المخي الجديد للدماغ، أي مع القدرة اللغوية والوعي الذاتي، لكنّها على اتصال مباشر مع ردود أفعالنا اللاشعورية. هذا التفصيل الفيزيولوجي للشّم يكشف لنا الترابط الضعيف بين الرائحة واللغة، التي مركزها الجانب الأيسر من الدماغ. في حين العلاقة بين الشّم والجانب الأيمن متوطدة جدًا، حيث الانفعالات والعواطف ويضاف إلى ذلك أنّ التعالق بين الشّم / الرائحة والذاكرة كبير جدًا وخاصة الذكريات المتداعية واللاشعورية. وإذا نظرنا إلى السلوك المنعكس عن رائحة ما، فهو أقرب لردود الفعل، حيث يأتي الحكم العقلي لاحقًا على خلاف البصر والسمع، ومن هنا استند أفلاطون في تفضيله للسمع والبصر على بقية الحواس واتبعته الثقافة الإنسانية في هذا التفضيل، حتى نستطيع أن نقول بأنّ المدونة اللغوية للروائح قليلة جدًا ومستعارة من بقية الحواس كرائحة واضحة/ العين، ورائحة دافئة/ الملمس، ورائحة شجية/ السمع، ورائحة لاذعة/ الذوق. وحتى الصفات المرتبطة بإدراك رائحة ما مأخوذة من أسمائها: عطر، نتانة… هذا الجفاف اللغوي لأسماء الرائحة ليس واقعيّا، بل نتيجة حملة تطهيرية شاركت فيها الفلسفة والأديان بحقّ حاسم الشّم والرائحة. ومن هذا المنطلق نستطيع أن نفهم إشارة مارك برادلي(5) إلى الندرة النسبية لأدبيات الرائحة(6) في العصور القديمة ولكي نوضح هذا التطهير الممنهج، فقد أوضحت الأبحاث بأنّ الشعوب التي مازالت تحافظ على تقاليدها القديمة وخاصة في تلك الجزر البعيدة عن تأثير الحضارة المزدرية للرائحة، تملك ذخيرة لغوية للرائحة تتجاوز مخزوننا من الكلمات المتعلّقة بها. يقال عن الشّم بأنّه حاسة الصمت، لكنّ الرائحة تتكلّم، وسنوجه عنايتنا إلى صوتها في الأدب، وكيف تم التعبير عنها.
الرائحة آلة سفر إلى الماضي:
تعتبر رواية البحث عن الزمن المفقود للروائي الفرنسي مارسيل بروست(7) مفصلًا هامًا في أدبيات الرائحة، فمن خلال رائحة ومذاق ملعقة من الشاي والكعك، انفتح الماضي على مصراعيه عبر تداع حرّ أمام بروست. لقد كان السؤال المضني، أين يذهب الزمن؟ مجابًا عليه من خلال الرائحة المرتبطة بالذاكرة العشوائية والعرضية للعقل البشري، فهناك يختبئ ما مضى من العمر. هذه الفكرة أصبحت تعرف بأثر بروست، حيث أكّد العلم الترابط التواشجي بين الرائحة والذاكرة.
تعتبر رواية باتريك زوسكند، العطر قصة قاتل 1985 من أهم أدبيات الرائحة. ففي أحد مشاهد الرواية عندما كان جان باتيست غرنوي طفلًا تحت رعاية الراهب تيرييه الذي شعر بأنّ هذا الطفل يخضعه لسلطة تحلّله، وتفكّكه، ولا تترك منه شيئًا مستورًا. لقد كانت هذه السلطة هي الأنف الخارق لغرنوي الذي يستطيع عبر الشّم أن يخترق تحصينات الذات البشرية للراهب: ” … كان يبدو أنّ هذا الاستكشاف الشمي يخترق حتى جلده، ويدخل في العمق”.
ولكي نفهم الرعب الذي استولى على الراهب تيرييه من قدرة الطفل غرونوي الشمّية على كشف دواخله، لا بدّ أن نذكر أن الطب من أبقراط مرورًا بابن سينا قد استند إلى شمّ روائح المريض من أجل الكشف عن علله، فلا غرابة أن يجزع الراهب أمام قدرة غرنوي الشمّية. في رواية موت مربّي النحل للارس جستافسون(8) يخاف الكلب من مالكه، ولا يتعرّف عليه من خلال رائحته المعتادة، فبعد إصابته بالسرطان أصبح الكلب لايجري نحو مالكه، إلّا بعد أن ينظر مالكه في عينيه والتكلم إليه مباشرة. لقد اشتم الكلب رائحة الموت المنبعثة من جسد مالكه المصاب بالسرطان، فأخافته تلك الرائحة.
إنّ لكلّ جسد رائحته الخاصة. ويذهب بعض العلماء إلى اعتبارها وراثية، لكنّ الرائحة حالة ثقافية نفهم من خلالها توجهات المجتمعات. إنّ النظافة المبالغ فيها، أو التعطّر، تهدف كلّها إلى إخفاء الجسد تحت انعدام الرائحة أو حجاب من العطر يخفي روائحه. ففي رواية مائة عام من العزلة لغابرييل غارسيا مركيز تدمن إحدى الفتيات العذراوات الاستحمام هازئة بكل العشاق، مزجية وقتها بقتل العقارب بين أحجار القرميد في الحمام، فيقودها هذا التطهير المستمر إلى أن ترتفع في الهواء وتختفي. فعلى ماذا ارتكز ماركيز في ذلك؟ ارتبطت الرائحة بالرغبة الجنسية، ولكي يتم تثبيط هذه الرائحة اقترح أحد الأطباء في القرن التاسع العشر الاستحمام كحلٍّ مجهض لهذه الرغبة. إنّ المشهد الذي أورده ماركيز يخدم الفكرة السائدة في ذلك الزمن عن الطهارة التامة والتي تكون بإزالة الرائحة بالمطلق.
إنّ ثيمة الرائحة قد بدأت في الظهور رويدًا رويدًا في الأدب متجاوزة التقسيم الكلاسيكي بين رائجة طيبة وأخرى سيئة. ولربما رواية زوسكند هي من جعلت من الرائحة بنية سردية متكاملة، لأنّها ناقشت المعضلة الوجودية لغياب رائحة الجسد بشكل جذري، فقد كان حال غرنوي الذي لم يجد أمام مشكلته الوجودية، أي انعدام رائحة جسده، إلّا أن يقتل كي يستخلص روائح ضحاياه، وينسبها لجسده الذي بلا رائحة. أمّا الروايات السابقة التي ذكرناها أعلاه ونزيد عليها رواية فوكنر، بينما أرقد محتضرة، ورواية عوليس جيمس، فقد كانت الرائحة أحد مداميك الرواية، وليست حبكتها الرئيسية قائمة على الرائحة كرواية زوسكند. قد يكون السبب في ذلك بأنّ الروايات السابقة كتبت في أزمنة ما قبل حداثية أمّا مع رواية العطر، فقد كانت الحداثة وما بعدها قد وقفت في وجه الازدراء الطويل الأمد بحقّ الرائحة.
تطرح الكاتبة دانوتا فجيلستيد(9) في مقال عن جماليات الرائحة كيف استطاعت ثلاث كاتبات، توني موريس، وجامايكا كينكايد، وجينيت وينترسون من خلال البحث في الرائحة البشعة ومقابلها العطر عن الكشف عن الأنساق الثقافية ومضمراتها في المجتمع، بحيث نستطيع أن نقول وفق كوجيتو ديكارت تعبيرًا عن محتوى مقال دانوتا الذي من الممكن اختصاره بالقول: (أنا لي رائحة؛ إذن أنا موجود). إنّ تغييب الجسد يسمح دومًا بانتهاكه، واستعباده، وإقصائه، وذلك الأمر يتم في جزء منه عبر الرائحة، أسواء بإلغائها عبر التطهّر، أو باستبدالها بعطور نباتية كما حصل في القرنين الماضيين وإقصاء كل عطر بمنشأ حيواني. وهذا التغييب للرائحة أكثر ما طال جسد الأنثى المشتهى والمغيّب خلف غلالة من اللارائحة أو الرائحة المرمّزة طهرانيّا. إنّ ما قدمته الروائيات من خلال تحليل دانوتا يكمن في حق الجسد الأنثوي أن يكون معبرًا عنه بروائحه الخاصة أو المستعارة، فالحرية تبدأ من الأنف، فقل لي كيف تشم، لأخبرك من أنت.
الثقافة العربية والرائحة:
تعود كلمة المسافة/ البعد إلى (ساف) التي تعني شمّ، فقد كان الإعرابي إن ضل طريقه في فلاة، أخذ التراب وشمّه وبذلك يعرف اتجاهه. هذه الدلالة اللغوية تخبرنا بأنّه قد كان لحاسة الشّم أهمية كبرى، لم يبق منها إلّا هذا المعنى اللغوي وجدع الأنوف، كما حدث مع قصير الذي لم يجد من طريقة يثبت بها للزبّاء خيانته/ خروجه عن صراط عمرو بن عدي، إلّا أن يجدع أنفه، كأنّه البدوي الذي أخطأ طريقه في البادية، فعوقب بقطع أنفه، لأنّه فشل في استخدام حاسة الشّم.
إنّ ما ذكرناه في مقدمة المقال عن تاريخ الرائحة يكاد ينطبق على تراثنا العربي، فقد تبنّى العرب نظرية الكيوف الطبيعية وشقّوا فسطاطها ما بين روائح نتنة، أو ذات دلالة جنسية وطبقية، أو روائح طيبة. ومع ذلك كان لهم مع العطور قصة جميلة. ارتبطت العطور بالمخيال العربي بأبي البشر آدم عليه السلام. حيث ذكر الطبري في تاريخ الرسل والملوك:”أنّ الله تعالى عندما أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض، جعل لا يمر بشجرة من شجر الجنة، إلّا أخذ غصنًا من أغصانها، فهبط إلى الأرض وتلك الأغصان معه، فلما يبس ورقها؛ تحات، فكان ذلك أصل الطيب”. هذه الرؤية الإسلامية، قد قامت على تقاليد جاهلية مفتونة بالعطر، فقد ضمّخ الشعراء الجاهليون قصائدهم بأبيات تتكلّم عن طيب عطر محبوباتهم. وهذا الأعشى يقول: إذا تقوم يضوع المسك أصورة/ والزنبق الورد من أردانها شمل. فيما امرؤ القيس يصف كيف تستيقظ محبوبته، فلا يغيب عنها العطر في نومها وصحوها: وَتُضْحي فَتِيتُ المِسكِ فوق فراشها/ نؤوم الضحى لم تتنطق عن تفضل. لم يكتف العرب أن يكون العطر ريحًا طيبة، بل ميثاقًا لأحلافهم، كما في حلف المطيّبين، وقسمًا لا يحنث به، فها هو دريد بن الصّمة، قد أقسم أن لا يتطيّب حتى يدرك ثأره. ومن أشهر العطور الذي ضرب به المثل: “أشأم من عطرمنشم”. إذ كانت العرب قبل الخروج في حروبها تتعطّر، وكأنّهم رغبوا، حتى وهم موتى، أن تفوح منهم الروائح الطيبة. لقد كان عطر منشم فألًا سيئًا لمن تعطّروا به، فقد كثر بينهم القتل، لكنّهم ماتوا معطّرين بالطيب. وإذا يممنا شطر وجهنا نحو العصرين الأموي والعباسي، نطّلع في كتاب الفهرست لابن النديم على ثبت في العديد من المؤلفات التي تتناول العطر وصناعته، فقد ألّف العديد من الكتّاب رسائل في العطر، نذكر منهم: الكندي، ويحيى بن خالد البرمكي، والمفضل بن سلمة. وقد كلّف المتوكل جحظة البرمكي بتصنيف كتاب له جاء بعنوان: في العطر.
شاعت العطور منذ القديم عند العرب، وكانت عبارة عن عجينة صمغية تحتوي المادة العطرية كالزبّاد الذي اشتهرت به عدن، ومن ثمّ تطورت صناعة العطور عبر نقع الزهور في زيوت وشحوم، فتمتصّ خلاصتها العطرية، إلى أن كان التقطير بواسطة الإنبيق . عرف العرب العديد من أنواع العطور منها؛ المسك والغالية التي راجت على يد أمراء بني أميّة. وقد احتفى العصر العباسي بالعطور، فبلغت شأنًا كبيرًا من الإتقان في الصنع، فأصبحنا نجد العطور كماء الورد، حيث يكون الحامل للعطر هو الكحول؛ وهي تشبه العطور المستخدمة حاليًّا.
لقد أخذ العرب العطر إلى أمداء أخرى عبر الكتابة به على القراطيس والكاغد وممن ترك لنا إضاءة مهمة في ذلك، كان الشاعر عمر بن أبي ربيعة(10). فبعد أن علم بزواج الثريا من غيره وهو في اليمن، دفعه الشوق إليها، أن يخطّ لها كتابًا جعل مداده من أخلاط العطر وكان مطلع كتابه: كتبتُ إليكِ من بلدي/ كتابَ مُوَلَّهٍ كَمِدِ. وعندما قرأت الثريا كتاب عمر، وتنسّمت روائح العطر التي تفوح منه ردّت إليه: أتاني كتابٌ لم يَرَ الناسُ مثلَه / أُمِدَّ بكَافُورٍ ومِسْكٍ وعَنْبَرِ. ويذكر الباحث عمر فرّوخ، بأنّ عمر بن أبي ربيعة كان له عطر خاص، يعدّه أحد عطّاري مكّه، ولا يصنع مثله لأحد. قد يكون ما ذكرناه عن كتابة عمر بن أبي ربيعة بالعطر من الأدلة القليلة التي أتتنا من العصر الأموي، لكنّ الأمر قد شاع في العصر العباسي. لم يدّخر العرب طريقة لإظهار شغفهم بالعطور، إلّا وطرقوا بابها. وما الكتابة بمداد مصنوع من العطر، إلّا إحدى هذه الوسائل وخاصة في أشعار الغزل والحكم والأقوال البليغة، فقد نقشت جارية إسحاق الموصلي على جبينها بالمسك: والعشق والكتمان ضدّان لا يجتمعان.
تنوّعت العطور بشكل كبير في العصر العباسي، حتى أنهم استخدموها في الكتابة، فقد كتبوا بالمسك والسّك والعنبر والغالية والحنّاء. وكأنّهم أرادوا بذلك أن يقرنوا طيب الكلام بطيب الرائحة والذوق. كانت الكتابة بالعطر نقلة جمالية أخرى للخطّ العربي، استكمل بها إظهاره بالحواس الخمس، فمن صورته البديعة التي أنشأها الخطاطون، إلى تصويته بالغناء والشعر كأحسن ما يكون، إلى نقشه على الفواكه، فيلمس ويذاق. ومع الكتابة بالعطر دخل الخطّ العربي حاسة الشّم. أمدّنا الوشاء في كتابه الموشى بشذرات جميلة عن ما كان يُكتب بالعطور على الجبين والخد. لقد تعشّق العباس بن الأحنف جارية كتبت على جبينها بالمسك: العين تفقد من تهوى وتبصره/ وناظر القلب لا يخلو من النظر. يتابع الوشاء أخبار من خطّوا بالطيب، فيذكر جارية كتبت بعطر الغالية على جبينها: إذا حجبت لم يكفك البدر فقدها/ وتكفيك فقد البدر إن حُجب البدر.
لعب العطر دورًا اجتماعيّا وثقافيّا في التراث العربي، فإلى جانب الرائحة الطيبة المنبعثة من الأجساد، كان شعرًا وخطّا وعشقًا. هذا الدور الكبير للعطر في التراث العربي دلالة على الإخفاء المتعمّد للرائحة وخاصة روائح الجسد.
إنّ التكلّم عن المدونة الأدبية للرائحة في تاريخنا الراهن يكشف لنا مقدار التعثّر في مقاربتها، فهي لم تتجاوز عناوين الروايات، أو النظرة الكلاسيكية لها، القائمة على التقسيم بين الرائحة الطيبة من ناحية، ومن ناحية أخرى البشعة، النتنة، مضافًا إلى ذلك التقسيم الجندري لها بين ذكر وأنثى، حيث رائحة المرأة الطيبة ورائحة الرجل المرتبطة بعرق العمل وخاصة في الشعر. وإن استندنا إلى كتاب الناقد رضا أبيض في كتابه؛ كتابة الرائحة في نماذج من الرواية العربية، والذي قارب فيه ثيمة الرائحة في بعض الروايات العربية، كرواية، تلك الرائحة لصنع الله إبراهيم ورائحة القرفة لسمر يزبك، ورائحة الجنة لشعيب خليفي وغيرها. نجد أن تحليل أبيض يسجل لنا فقر واقع أدبيات الرائحة في الرواية العربية وإن كان بشكل نسبي، لكنّه دال على أنّ سرديات الرائحة مازالت على الشط تغترف من تراث الرائحة التقليدي وتؤكّد هيمنة البصري والسمعي على رؤيتنا الوجودية: ” ستحفظ لنا مثل هذه الروايات ذكرى تشكل الرائحة في أبنية وخطابات روائية، لكنها لن تكون ذات فاعلية وقوة وتأثير ما لم يتعهد الخطاب النقدي ومضاتها واختراقاتها بالقراءة والاهتمام، وما لم يتعهدها الخطاب الإبداعي ذاته بالإنصات تناصا وحوارا وتجاوزا”.
وختامًا لهذا المقال لا بدّ من التنويه إلى أنّ حاسة الشّم جسر بين نوعين من الحواس المنفصلة عن علاقتها بالأشياء كالسمع والبصر، والمتصلة معها كاللمس والذوق، فالشّم من ناحية منفصل عن الشيء مصدر الرائحة، لكنّه في الوقت نفسه متصل به من خلال آلية عمله الكيميائية، فعندما يتنسّم الأنف رائحة عبير زهرة ما، فإنّه يلتقط ذرات الرحيق المتطايرة منها. هذه الطبيعة المزدوجة لحاسة الشّم هي من دفعت بروتون إلى القول: “إنّ الشّم هو الحاسة الأقل تغيرًا، والأقل قابلية للوصف من بين جميع حواسنا، في نفس الوقت الذي يعدّ فيه حاضرًا للغاية، ومؤثرًا للعمق في سلوكنا”.
باسم سليمان
خاص ضفة ثالثة
المصادر:
الرائحة أبجدية الإغواء الغامضة، بيت فرون. هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث 2010.عالم جديد شجاع، ألدوس هسكلي. عالم الكتب- القاهرة 2016.قلق في الحضارة – سيغموند فرويد. الطليعة للنشر- بيروت 1977.انتروبولوجيا الجسد والحداثة، دافيد لو بروتون. مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع – بيروت 1997.https://bmcr.brynmawr.edu/2015/2015.09.51/https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0301006616688224https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/02/how-scent-emotion-and-memory-are-intertwined-and-exploited/انتروبولوجيا الجسد والحداثة، دافيد لو بروتون. مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع – بيروت 1997.https://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/pdf/cauce24/cauce24_37.pdfالعرب في حضارتهم وثقافتهم إلى آخر العصر الأموي، عمر فروخ. دار العلم للملايين- بيروت1966

https://diffah.alaraby.co.uk/diffah/revisions/2022/9/1/%D8%B9%D9-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%D8%B4%D9-%D9%D9%D8%B0-%D8%A3%D9%D9%D8%A7%D8%B7%D9%D9-%D8%A5%D9%D9-%D9%8A%D9%D9%D9%D8%A7?fbclid=IwAR0WZ6ZQJqR8g4Hr7Re5nksW-O5_eC3BXQTqx87Px0JVObTZsS4dtGRH160 https://diffah.alaraby.co.uk/diffah/revisions/2022/9/1/%D8%B9%D9-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%D8%B4%D9-%D9%D9%D8%B0-%D8%A3%D9%D9%D8%A7%D8%B7%D9%D9-%D8%A5%D9%D9-%D9%8A%D9%D9%D9%D8%A7?fbclid=IwAR0WZ6ZQJqR8g4Hr7Re5nksW-O5_eC3BXQTqx87Px0JVObTZsS4dtGRH160
August 20, 2022
لو كان الله يضمّنا ويشمّنا، هل كنّا أكثر إيمانًا به؟ مقالي في رصيف 22- باسم سليمان
كانت الديانات الماقبل توحيدية لا تمنع تصوير الآلهة، فالمرئي دليل على اللامرئي، فالتمثال أو اللوحة، أسواء كانت لعشتار أو زيوس، هي تجلّ لهما، وإن كان جوهر عشتار أو زيوس أعمق من الرسم أو النحت. لم تبخل الديانات الوثنية في إلباس الآلهة صفات إنسانية ليس أولها الغيرة عند عشتار، ولا آخرها الخيانة عند زيوس، بل أخبرتنا عن طعام الآلهة المسمى النكتار الذي يمنحها الخلود. ووصفت لنا حركاتهم ودماءهم النازفة، وأن إله النوم قادر على جعل زيوس يغمض جفنيه ويغرق في نوم عميق. وعندما جاءت الديانات التوحيدية بدأت العمل على المباعدة بين السماء والأرض، على الرغم من أنّ النص التوراتي أشار بوضوح إلى أنّ الإله قد خلق الإنسان على صورته: “فَخَلَقَ اللهُ الإِنْسَانَ عَلَى صُورَتِهِ. عَلَى صُورَةِ اللهِ خَلَقَهُ. ذَكَرًا وَأُنْثَى خَلَقَهُمْ” ومع ذلك نصّت التوراة على حظر إنشاء أي تصوير، أسواء كان للإله أو لمخلوق أو شيء آخر: ” لا تَصْنَعْ لَكَ تِمْثَالًا مَنْحُوتًا، وَلاَ صُورَةً مَا مِمَّا فِي السَّمَاءِ مِنْ فَوْقُ، وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ تَحْتُ، وَمَا فِي الْمَاءِ مِنْ تَحْتِ الأَرْضِ”. لم يشذ الإسلام عن هذه القاعدة حيث وجدت أحاديث تحذّرالرسام أو النحات من صنع صورة أو تمثال. جاء عن ابن مسعود عن الرسول: “إنّ أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصوّرون”. خالفت الديانة المسيحية هذا النهج وازدهر التصوير الديني وخاصة الأيقونات، حيث نجد صورة الله والمسيح ومريم العذراء والقديسين. ولم يمنع هذا الاتجاه الحرب الشعواء التي قادها الإمبراطور البيزنطي ليون الثالث عام 725 ميلادية ضد الإيقونات، إذ سرعان ما انتهت هذه الحرب ضد الصور.
تطرح قضية التصوير بأنّ لله أعضاء كأعضاء الإنسان، رأس وصدر وقدمان ويدان، بل له حواس خمس، السمع والبصر والشم والذوق واللمس. وأكثر من ذلك، فهناك أعضاء تناسلية كما يذكر جاك مايلز في كتابه؛ سيرة الله. لقد طلب موسى أن يرى يهوا، ولكن أخبره أنّه لن يرى وجهه أبدًا عندما يمرّ من أمامه. لم ير موسى وجه يهوا، لكن رأى بدلًا من ذلك، يهوا يستر بيده أعضاءه التناسلية. في المسيحية المتحرّرة تجاه قضية التصوير كان المسيح واضحًا، بأن من يراه كأنّه رأى الله. أمّا في الإسلام، فقد جاء في القرآن وصف الله بأنّه سميع بصير إلّا أنّه نور، مع أنّه في قصة الإسراء والمعراج أورد القرآن بأنّ الرسول رأى ربّه، لكن لم يشرح طبيعة ما رآه، فأكمل هذا النقص بالحديث القدسي: “رَأَيْتُ رَبِّي فِي صُورَةِ شَابٍّ أَمْرَدَ، لَهُ وَفْرَةٌ جَعْدٌ قَطَطٌ، فِي رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ”.
إنّ تواتر هذه القصص عن صورة الله في الديانات الثلاث التوحيدية، يدفعنا إلى السؤال عن حواسه. هل له عين ترمش، وأذن بصيوان، أو أنف يشم، وفم ينفخ الهواء، ويد تلمس؟
كان القرآن واضحًا بأنّ الله سميع بصير، كذلك فعلت التوراة والأناجيل، لكن لم تذكر إشارة واحدة عن الأذن والعين في تلك الكتب، فآلة السمع والرؤية التي بموجبها نسمع ونرى يفترض أن تكون موجودة عند الله بمقتضى الحديث المذكور آنفًا، وبموجب مقولة المسيح والحادثة التي طلب فيها موسى رؤية الله. كيف نفسر إذن هذا الغياب لآلة السمع والبصر عند الله؟ لربما أجابنا أفلاطون عن ذلك، فقد اعتبرهما أشرف الحواس لارتباطهما بالعقل، وكأنّه يشير إلينا إلى أنّ رؤية الله وسمعه قضية عقلية ليست بالعين ولا بالأذن. وهذا التفسير نجده بالتعبير الفلسفي عن الله، بأنّه طاقة عقلية بلا آلة الدماغ، فمن المنطق أن لايكون له أذن ولا عين كما البشر. إن ترفّع العين والأذن عن التعاطي المباشر مع أشياء الطبيعة على عكس اليد والأنف والفم هو ما سمح لهما أن يكونا وصفًا لله من دون أن يكون ذلك تجسيم له. هذا التعالي للعين والأذن لم يكن متاحًا لإظهار آلات بقية الحواس: اليد والأنف والفم، لذلك استبعدت من أن تكون وصفًا لله. ومع ذلك ظلّت بعض النصوص الدينية تذكر تلك الحواس، على الرغم من علاقتها المباشرة مع الأشياء.
اللمسة الداعمة لله:
عندما رسم مايكل أنجلو سقف كنسية سيستينا في الفاتيكان، صوّر الله مادًا يده إلى آدم مشيرًا بسبابته إليه، يكاد يلمس أصابع يد آدم الممدودة إليه بتراخٍ. تُظهر لنا اللوحة الله في سمائه محاطًا بالملائكة وآدم مستلقيًا على الأرض مستندًا إلى يده اليمنى، فيما يده اليسرى ممدودة إلى الله بفتور جليّ، على عكس الله الذي يبدو جادًا أكثر من آدم في اللمس! فهل كانت هذه اللمسة هي التي منحت آدم الحياة مع أنّ النص التوراتي يشير إلى أنّ الحياة قد منحت إلى آدم عبر نفخ نسمة الحياة فيه، أم أنّ تلك اللمسة كانت بعد أن أخطأ آدم وطرد من الجنة، فجاءت تلك اللمسة كإعادة تطويب ثانية لآدم لكي يكون خليفة الله على الأرض. لكن كيف نقرأ تراخي يد آدم، حيث لا نجد تلك الإرادة المندفعة التي رأيناها من قبل الله في اللوحة.
كان إرميا كما تذكر التوراة شابًا، لا يعرف كيف يتنبأ، لذلك تهرّب إرميا من تكليف الله له بأن يكون نبيّا. ومع ذلك أصرّ الله، ولمسه على شفته: “وَمَدَّ الرَّبُّ يَدَهُ وَلَمَسَ فَمِي، وَقَالَ الرَّبُّ لِي: هَا قَدْ جَعَلْتُ كَلاَمِي فِي فَمِكَ”. هكذا صنعت لمسة من يد الله نبيّا ومنحته القدرة على التكلم بالنبوءات.
تتكرّر تلك اللمسات، لكن عبر الملائكة، كما مع أشعيا ودانيال. وكان الهدف منها تقوية الرسل ليحملوا كلمة الله بأفواههم. وكأنّنا مع معنى اللمسة البشرية التي تطمئن وتدعم وتمنح الثقة. والآن نستطيع أن نفسر تباطؤ يد آدم عن الإسراع إلى ملامسة يد الله، فهو كان مثل إرميا وأشعيا ودانيال لا يجد في نفسه القوة ولا الموثوقية ليكون محل كلمة الله، وخاصة بعد أن خان ثقة الله وأكل من الشجرة المحرّمة، فأتت لمسة الله لتجبر ضعف الإرادة في آدم، وتخبره بأنّ هناك فرصة ثانية.
لا يظهر الله في الأناجيل كما في التوراة، فقد حلّ مكانه المسيح الذي يقول: “اَلَّذِي رَآنِي فَقَدْ رَأَى الآبَ” ويكرّر المسيح أفعال اللمس التي رأيناها في التوراة لمنح البركة والشفاء من الأمراض وتطويب التلاميذ ودعمهم في لحظات شكّهم، كما فعل مع توما عندما جعله يلمس أثر المسامير في يديه. ونستطيع أن نعدّ تلك اللمسات وفق العقيدة المسيحية التي قام بها المسيح هي لمسات من الله.
لا نجد في القرآن موضوعة اللمس التي وجدناها سابقًا في التوراة والإنجيل، لكنّنا نجد اليد في العشرات من الآيات، لربما أقربها إلى موضوعنا هي: “يد الله فوق أيديهم” وهي تلعب ذات الدور الداعم الذي رأيناه سابقًا.
قبلة الحياة:
تعود إلى برومثيوس فكرة إطعام الآلهة رائحة الشواء، والتي نجد تطبيقًا لها في مسرحية الطيور لآريستوفان التي تقوم فكرتها على أنّ صديقين من الشعب الأثيني بعد أن ضاقا ذرعًا من الحروب، قرّرا أن يهاجرا إلى عالم الطيور ويسيطرا عليها ويقنعاها بأن تأكل جميع الحبوب والنباتات، فتصيب المجاعة البشر، وأن تطير بأسراب حتى تحجب دخان الأضاحي عن الآلهة، ممّا سيسبب جوع الآلهة التي على ما يبدو تتغذّى من خلال أنوفها وأفواهها باستنشاق رائحة الشواء. يزور برومثيوس هذين الصديقين ويقنعهما بأن يفرضا شروطًا قاسية على الآلهة التي ستوافق عليها بسبب جوعها لتنسّم دخان الأضاحي.
يحذّر أفلاطون من تأثير الروائح على القرارات العقلية، فهل كان الله غافلًا عن ذلك وسمح لرائحة الأضاحي التي قدمها نوح بعد نزوله من السفينة وانتهاء الطوفان الذي أباد البشرية، أن يقسم، بأن لا يلعن الأرض ولا كل حيّ: ” فتنسّم الرب رائحة الرضا” كما جاء في التوراة. تعني كلمة (تنسّم) شمّ الريح المشبعة بالروائح.
تستدعي هذه القصة سؤالًا، هل لله جهاز تنفسي؟ يستنشق الهواء من خلاله ويزفره! جاء في التوراة: “وَجَبَلَ الرَّبُّ الإِلهُ آدَمَ تُرَابًا مِنَ الأَرْضِ، وَنَفَخَ فِي أَنْفِهِ نَسَمَةَ حَيَاةٍ. فَصَارَ آدَمُ نَفْسًا حَيَّةً”. إنّ فعل النفخ يذكّرنا بقبلة الحياة التي تمنح الغرقى الهواء. جاء في سفر أيوب: “إنّه ما دامت نسمتي فيّ، ونفخة الله في أنفي، لن تتكلم شفتاي إثمًا، ولا يلفظ لساني بغش”. إنّ النفخ آلية لإعطاء الحياة وخلقها، حيث نجد في القرآن أنّ كلمة نفخ تعني منح الحياة، بدءًا من النفخ في آدم، فأصبح حيّا بعد أن كان صلصالًا، ممّا رتب سجود الملائكة له، إلى نفخ في تماثيل طينية على هيئة طيور على يد المسيح، فرفرت كطيور حقيقية، إلى النفخ في فرج مريم: ” وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ”.
أصبح لدينا بعد تلك العجالة فعلين معبّرين عن جهاز التنفس الإلهي: التنسّم والنفخ. الأول أعطانا إشارة إلى أنّ الله يشتم الروائح. والثاني يمنحنا فكرة بأنّنا قد نشتم رائحة الله، كما قال أيوب. لكن هل يشتم الله الروائح البشعة؟ تحذّر مرتا أخت إليعاز المسيح عندما طلب فتح القبر، بأنّ الرائحة ستكون نتنة، كما جاء في إنجيل يوحنا. مهما يكن من أمر حاسة الشم لدى الله، لكنّها تفتح لنا بابًا إلى مفهوم الطهارة الجسدية المطلوبة من المؤمنين في الديانات السماوية الثلاث، حيث يجب على المؤمن أن تكون رائحته زكية دومًا، فالله يتأذّى من الرائحة المنتنة لذلك صرخت مرتا بالمسيح كي لا يعرض حاسة الشم لديه لنتانة الجثة.
حواس الحبّ:
مهما تم مدح حاستي البصر والسمع، أسواء لدى الله أو البشر، لكن لنقل بصراحة، أليست اللمسة أو الضمة أو التربيتة على الكتف في كثير من الأحيان، أجمل وأكثر أهمية في منح الرضى من السمع والبصر، فكيف لو كانت تلك اللمسة من يد الله! أليست رائحة الأم، هي الوسيلة المثلى لبث الطمأنينة في قلب الطفل، فماذا لو كنّا قادرين على شمّ رائحة الله وبالأحرى أن يشم هو عرقنا في سعينا نحوه! أليست الأنفاس الحرّة بين عاشقين تعادل كل كلمات الحب، فماذا لو قيض لنا أن نتنسّم أنفاس الله عندما يغمرنا بعطفه ولطفه.
باسم سليمان
رصيف22

August 18, 2022
بين ضفاف الرمل وجسور الماء، فلنرسم الماندالا- قراءتي ارواية ماندالا للروائي الأردني مخلد بركات في موقع رصيف22
يقول أفلاطون في كتابه القوانين: “بأنّنا دمى الإله وعلينا أن نلعب حياتنا بطريقة جيدة”. لم يكن أفلاطون إلّا أول المحذّرين بأنّ الواقع الذي نحياه، ما هو إلّا مجرد وهم. لقد عبّر عن هذه الفكرة بقصة الكهف واستفاض في شرحها، عندما بيّن بأنّ الواقع هو محاكاة مزيفة عن ما هو حقيقي. لكن بعيدًا عن التفسير الميتافيزيقي لمقولة أفلاطون والتي يجب قراءتها وفق اللحظة التاريخية التي قالها فيها. لقد كانت أثينا مهزومة من قبل إسبارطة، وإن كانت هذه الهزيمة قدرية، لكنّها مزيّفة، فالواقع التاريخي مجّد أثينا لا إسبارطة.
العبِ اللعبة:
ترك لنا أفلاطون فسحة للأمل تتمظهر في عالم المثل، وذلك بأن نخرج من ذلك الكهف إلى ضياء الحقيقة، لكن مع رواية (ماندالا) للروائي الأردني مخلد بركات الصادرة عن دار الأهلية يبدو الأمل معبرًا عنه بأعظم مخاوف الإنسان، ألا وهو الفناء التام كنجاة نهائية من الخيوط القدرية التي تحكم حيوات البشر، أسواء كان ذلك في الواقع المزيف، أم في عالم المثل/ ما بعد الموت! فهل يعني ذلك أنّه لا إمكانية لنا أن نلعب حياتنا بطريقة جيدة؟
لقد ذكر هيدغر في كتابه؛ مبدأ السبب بأنّ الترجمة الأصح لمقولة الفيلسوف ليبنتز: “وجِد العالم بينما كان الإله يحسب”؛ هي: “وجِد العالم بينما كان الإله يلعب”. هل يحسب تعني يلعب، أم أن هيدغر وهو الشاهد على عنف الإنسان في القرن العشرين يدعونا لأن نخفّف من جدية نظرتنا إلى قدرية سياقات هذا الكون، فهذه اللعبة التي يخوض غمارها الإنسان، والتي لا ترى في اللاعبين إلّا مجرد دمى المسرح الأوديبي، حيث لا نجاة من خيوط القدر، حتى لو تم قطعها، كما فعل أوديب عندما سمل عينيه، فاللعبة مستمرة وفق خيوط أخرى تمسك الدمى من أرواحها. ولذلك لا حلّ إلّا بأن نلاعب اللاعب الأكبر بما يظن أنّه يحكمنا من خلاله، أي بالحياة والموت، وذلك بأن نجعلهما طوع إرادتنا. ولنضع مقابل مرآة القدرية مرآة الاحتمالية، حيث تصبح الغايات كلمة في جملة نكتبها نحن، لا أحد آخر.
يعلن شكسبير بأنّ المسرحية هي كل شيء، لا شيء خارجها. هذا المعنى جاء ما يشبهه على لسان ميساء إسحق تلك الأنثى التي سلبت عقل الدكتور صلاح العوّاد المختصّ في علم النفس، والذي كان في خضم محاضرة بعنوان: (تفكيك الشخصية العربية المهزومة من منظور علم النفس). أدخلت ميساء الدكتور صلاح في مرايا لعبة ماندالا، هي سيدتها، معلنة زمن الفضيحة، فالرمل هو مرآة في النهاية، والمرآة سراب في خاتمة الغايات، والسراب ماء يولد منه اللاعبون من حبر راوٍ عليم بكل شيء، هكذا صوّرته ميساء في ذهن صلاح العوّاد، لكن لماذا أشار الراوي العليم الذي له هيئة قزم إلى سحابة قطنية عندما جاء صلاح إلى ميعاد اللقاء مع ميساء، ولم يجدها في شارع الملك فيصل، قرب نصب دلّة القهوة العربية في العاصمة عمّان! هل كان يحذّره من ميساء، أم يورطه أكثر باقتفاء الأثر وهو ابن الصحراء؟ أليس الدكتور صلاح سليل الأعراب الأوغاد الذين خرجوا من رمل الصحراء وغيّروا مرايا العالم ورسموا ماندالاتهم الخاصة، فما الذي حدث حتى هزموا أمام الصهاينة! كأن يغرق صلاح في مقتبل عمره في بئر رومانية في عام 1967 أو تقتله رصاصتان في العنق بسبب انتسابه إلى الحزب الشيوعي، في معتقل مبنيّ في صحراء كأنّه ساعة رملية من خليج الرمل إلى محيط الرمل.
الماندالا نوايا الرمل والماء:
تسرد الرواية حيوات عدّة أشخاص عبر انعكاسات مرايا عديدة، فمن صلاح البدوي الشيوعي الأردني الدكتور في علم النفس، إلى يحيى التنوري الشاعر المندائي العراقي حفيد المتنبي، إلى عبد السلام العياشي الثوري المغربي الذي قاتل عن فلسطين في بيروت، إلى شوكت الضبع المسيحي صديق السلاح مع العياشي في الدفاع عن ست الدنيا، إلى هدية البصري التي قُتل أبوها البعثي الذي رفض دخول العراق إلى الكويت، فاغتيل من رفاقه في الحزب، إلى صيته ابنة عم صلاح من عمّه مجحم العسكري الذي عاد من هزيمة حزيران وأيامها الستة شهيدًا. هذا السرد يقابل بمرآة ميساء التي تكشف لصلاح سرابية هذه الحكايات، فيحيى ليس إلّا عميلًا سهّل للأمريكان دخول بغداد. والعياشي ليس إلّا داعشيّا في بلاد الشام، مبدِع حرق الأسرى في الأقفاص. وشوكت الضبع ليس إلّا سارقًا. وهدية ليست إلّا ابنة ذلك البعثي الذي قتله يحيى التنوري الذي بدّل بندقية قلمه من الكتف الشيوعي إلى الكتف البعثي، أمّا صيته، فليست إلّا أخت صلاح من أبيه بعدما جبّ عقم أخيه مجحم.
هل انتهى تعاكس المرايا بين صلاح وميساء؟ أبدًا فالمرايا انعكاساتها تمتد إلى الأبد، حيث صلاح كان نزيل معتقل في صحراء تم تصفيته فيه، ودفن في زاوية زنزانة عبد السلام. ذلك الثوري الأخير الذي شعر بحجم المؤامرة عندما أدرك أنّ السفينة التي أقلّت الثوار الفلسطينيين إلى تونس ليست سفينة نوح، فلم يبق له إلّا أن ينتظر تلك الخيول البيضاء التي عقد النصر بأعرافها، والتي أخرجت للنبي إسماعيل وستعود في آخر الزمان. وليس المندائي إلّا شاعرًا شيوعيّا صار بعثيّا بقدرية التاريخ، وتزوج من هدية البصري قبل أن يقتل رفاق الدرب أباها، ليكتشف أنّها خنثى، فلا يضنّ بها، فينجوان عبر تمثيل لقاء شاعر بأنثى محجبة على ضفاف دجلة، هي تقصّ له حكاية مقتل أبيها، وهو يروي شغفه وشغفها بين ذكر وأنثى عندما عارضتهما البيولوجيا باستثناءاتها. فيما ينتهي شوكت الذي قبض على ضبع وقيّده بحزامه وجرّه إلى معسكر الفدائيين تعبيرًا عن رغبته بالقبض على كل الضباع التي تهدّد بيروت، إلى أن يكون نزيل كرسي متحرّك، تستجدي زوجته المال من أجل دوائه.
تتكاثر المرايا كحبات الرمل في الرواية، فالموتى أحياء، والأحياء موتى، والموت مرآة الحياة، والحياة رمل الموت؛ هكذا تقود ميساء صلاح في الماندالا التي تتجلّى بأشكال عديدة كالنجمة السداسية الموشومة على جسدها، لتكشف له عن ست لوحات لشخصيات الرواية وست غرف تكشف فيها أسرارهم، وأمام باب كل غرفة تضاجع ميساء صلاح لتنجب منه ستة أطفال، وكأنّهم الأيام الستة للهزيمة، وكل ذلك يتدفّق من حبر القزم الراوي العليم الذي تقود ميساء قطاره المليء بالركّاب إلى معتقل آخر. لكن من هي ميساء: إنّها ميساء اتسحاق مردخاي من يهود الدونمة الذين حاولوا أن يقنعوا السلطان عبد الحميد أن يعطيهم فلسطين.
هل بذلك وصلنا إلى الذروة السردية حيث تتفكّك الانعكاسات إلى رمل وضوء، لن يكون ذلك متاحًا قبل أن نملك المفاتيح التي وردت على لسان الشخصيات، كي لا تكون نهايتنا الفجائعية مثل صلاح، الذي لم يكن له من حل أمام ديكتاتورية الراوي العليم إلّا بأن يهرب من قطار السرد إلى موته الحقيقي، لكي يخرج من اللعبة السردية التي تنحت تاريخ المنطقة في ظلمة أقبية المعتقلات والهزائم المتكرّرة أمام عدو استحوذ على صناعة البورتريهات، فشكّلها كما يريد، فالثوري يصبح داعشيّا بموجب قوة من يملك الخطوط والألوان، فيما يغدو الشيوعي بعثيّا بسطوة الريشة وإطار اللوحات.
ليس عنوان الرواية إلّا مفتاحًا لبنيتها السردية، فالماندالا تمثّل رسمًا تجريديا عن الكون والتي اعتبرها يونغ وسيلة لكشف الوعي الجمعي واللاشعور وتأخذ أشكالًا عديدة. كانت الماندالا تعتبر وسيلة لدفع السحر أو الوهم عن عين الناظر إلى واقع هو محاكاة زائفة للحقيقة. وهذا ما تلعبه رواية مخلد بركات، فهي ماندالا سردية على القارئ أن يلوّن أشكالها، أي أن يفكّ الرموز التي نشرها الروائي على ألسنة شخصياتها وألّا يكون كميساء التي ارتهنت عن وعي لتلك اللعبة الجهنمية التي يخطّها القزم لتكون ضحية لسرد تاريخ متوهّم عن أرض الميعاد، فتصنع من سرابه يقين الوهم.
لم تكن ميساء اتسحاق مردخاي ضنينة بالأسرار على صلاح، وكأنّها لم تعد تخشى شيئّا، فاللعبة السردية لتاريخ المنطقة أصبحت فضيحة لا تستر عوراتها بالأسرار، فلقد أسرّت له بكل تفاصيل اللعبة التي لا فكاك منها، حتى وهو يرى أطفاله منها يساقون إلى ذات المعتقل الذي ضمّه مع العياشي ويحيى، هكذا شعر صلاح بأنّه لا جدوى حتى من البكاء بين يدي زرقاء اليمامة.
أنتَ إنسان حرّ، فاقطع خيوط الدمى: كان القطار الذي تقوده ميساء يشقّ رمل الصحراء إلى معتقل ماورائي، يجلس بجانبها القزم الذي ما فتئ يكتب الماضي والحاضر والمستقبل في هذه المنطقة، أليست هزيمة حزيران هي الحبر الديكتاتوري والاستعماري؟ الذي يخطّ في اللوح المشطور إلى رمل وماء جغرافيا الموت في هذه البلاد، التي تمتدّ بشكل أفقي كساعة رملية، لا يتحرّك فيها الزمن، ولا الرجاء.
كان أوديب شجاعًا عندما قطّع خيوطه / سمل عينيه. وكان صلاح شجاعًا عندما هرب إلى موته الحقيقي، لكن مَن سيقتل ذلك القزم الذي يتحكّم عبر سواد حبره ببياض الأنفس البشرية ويحولّها إلى ليل معتقل في زنازين، ليس أولها سجون الأنظمة العربية، وليس آخرها غوانتانامو وسجن أبو غريب.
تبدو الإجابة التي تطرحها الرواية، بأنّنا حتى نلعب أدوارنا بشكل جيد في الحياة، لا بدّ أن نثور على السرديات المتقيّن منها والمتشكّك بها في تاريخ المنطقة. إذن لنكسر الخشبة التي سنمثّل أدوارنا عليها ومن ثم نصلب، ولنهدم المسرح، ولنرمي المخرج في كواليس جنونه، ولنخرج إلى الضياء، فلن يخسر الموتى غير الدود في قبورهم. لكن إنْ خرجوا إلى الضياء، فهناك احتمالية أن تتحوّل الديدان إلى فراشات، فأجمل ما في هذه اللعبة الكونية ليس القدرية، بل إمكانية أن نكون قادرين على خلق موتنا وحياتنا سواء بسواء. وكأنّنا في جلسة تحليل نفسي حيث نسمح للمكبوت الذي يتحكّم في ماضينا وحاضرنا أن يخرج إلى العلن بخيره وشره، فليس من عورة نخجل منها غير أن نترك مستقبلنا بيد لعبة جهنمية، لا رمل لنا فيها ولا ماء، ألهذا أشار السارد الأكبر إلى تلك الغيمة المتمثّلة بميساء، وكأنّه يقول لصلاح بأن ميساء قد تماهت مع اللعبة، فثرْ أنت، وحرّرني من قيد قدريتي وامنحني ألوهية الاحتمالات.
باسم سليمان
خاص رصيف22
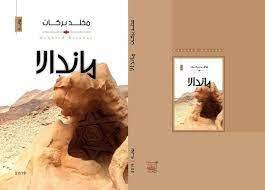
August 5, 2022
الأنف… البوصلة التي أضعناها في فوضى المرئي والمسموع – باسم سليمان- مقالي في رصيف22
هل فقد الأنف حظوته لدى الكائن البشري عندما انتصب واقفًا؟ فتراجع نصيبه من الاهتمام مقابل الحواس الأخرى، حتى أنّنا نتكلّم عن الرائحة متناسين بأنّه لولا الأنف لكانت ثقافة الرائحة والعطور، لا وجود لها. لقد ازدرى أفلاطون العطور ولم يذكر الأنف في هجائه! بينما أشاد بتفوّق البصر والسمع على الحواس الأخرى في مسيرة الإنسان التطورية، فهي الحواس الفاضلة وغيرها أقرب للحيوانية. كان الإغريق يزدرون العمل وبالتالي اليد وحاسة اللمس. ومع أنّ الإنسان في لحظة احتضاره الأخيرة يزفر آخر أنفاسه، إلّا أنّ الإغريق كانوا يقولون: أطلق نظرته الأخيرة، كما يذكر ريجيس دوبريه في كتابه حياة الصورة وموتها. وعلى الرغم من هذا التجاهل للأنف كدلالة على الحياة عند الإغريق، إلّا أنّهم أورثونا أسطورة أنوفهم وعلى ما يبدو فقد أجروا عمليات تجميلية فنيّة على منحوتاتهم، حتى أصبحنا نتكلّم عن الأنف الإغريقي المستقيم مع أنّ الواقع لا يؤكّد انتشار هذا الأنف بينهم. هذه المفارقة الإغريقية تكشف لنا أهمية مضمرة للأنف، سواء أكانت جمالية أو ذات دلالات ثقافية اجتماعية أو مكانًا لتطبيق العقوبة الجزائية.
إنّ نظرة عابرة على أكثر التماثيل القديمة تسمح لنا بملاحظة أنوفها المكسورة والمحطّمة، وليس السبب الرئيسي في ذلك عوامل الطبيعة، بل إنّ هناك أسبابًا أخرى منها التشويه المتعمّد. وقد جمعت في خزنة في متحف كوبنهاكن عشرات الأنوف المزيّفة التي أزيلت عن التماثيل من أجل أن تكون المنحوتات أكثر أصالة. كان للأنف نصيب الأسد من العقوبات الجسدية التي كانت تطبق في الأزمنة القديمة. تذكر لنا الإلياذة هذه العقوبة حتى إنّ هرقل نال لقب قاطع الأنوف، لأنّه جدع أنوف من أخبروه بما لا يود سماعه. كانت عقوبة قطع الأنف تطبق على من يعترضون السفن وفق تشريع الفرعون حور محب. وفي الإمبراطورية البيزنطية جدع أنف الإمبراطور جوستنيان الثاني كي لايعود إلى سدة الحكم، لأنّ الإمبراطور يجب أن يكون خاليّا من أي تشوه كوجه الله. وعلى الرغم من ذلك عاد واستلم الحكم، لكن بعد أن توسط وجهه أنف من ذهب. كانت هذه العقوبة منتشرة في كل أنحاء العالم. فالقاعدة الشهيرة في التوراة؛ العين بالعين والسن بالسن ستقود إلى جدع أنف بأنف. كذلك لم يخلو القرآن من النص على عقوبة تطال الأنف بالذات: “سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ” والوسم الكي بالنار على الأنف، وقد استخدم القرآن كلمة الخرطوم وهو اسم أنف الفيل دلالة على التشهير الأقصى لمن ستناله العقوبة، حيث أنّ الأنف/ الخرطوم جاذب للنظر بشكل كبير. إنّ هذه العقوبات التي تطال أنف الإنسان الحقيقي ستجد طريقها إلى وجوه التماثيل المنحوتة، لأنّ التماثيل لم تكن قديمًا مجرد نحت جمالي، بل كانت دلالة على سلطة ودين ومذهب وعقائد، وعندما تتبدل الدول تطبق العقوبات من السلطات الجديدة على ما كان يمثل السلطة القديمة مهما كان شكلها.
لأمر ما جدع قصير أنفه:
هذا المثل يضرب بالمكر والحيلة، كان قصير تحت يد عمرو بن عدي، وهو ابن أخت جذيمة الأبرش الذي قتلته الزباء انتقامًا لمقتل أبيها على يده. قرّر عمرو الانتقام، فما كان من قصير إلّا أن طلب من الملك عمرو أن يجدع أنفه دلالة غضبه عليه، لكنّ الملك رفض، فقطع قصيرٌ أنفه، وذهب إلى الزباء مع دليل لا يقوض بأنّ الملك عمرو قد غضب عليه وأقصاه. صدّقت الزباء قصير، فالأنف المجدوع لا شك بعده وأسلمته أسرارها، وبعد أن استأمنته انتقم منها.
لقد اختار قصير الأنف من بين جميع أعضائه، لربما لو سمل عينًا أو قطع أذنًا لكان تحقق المطلوب، لكن قصير يعرف تمامًا الدلالات العميقة المرتبطة بالأنف، والتي تجعل من الأنف رمزًا للعلو، وفي الوقت نفسه رمزًا للطاعة وأخيرًا النفي من المجتمع البشري. اشترك الشعراء في إيراد صورة الأنف عند المدح، يقول حسان بن ثابت: بِيضُ الوُجُوهِ، كَرِيمةٌ أَحْسابُهُم
شُمُّ الأَنُوفِ من الطِّرازِ الأَوَّلِ.
وعندما كان العرب يريدون وصف جمل طيع ولين وسهل القياد يقولون: جمل أنِف. هذا التناقض في المعنى بين الرفعة والانقياد يؤكّد خطورة الأنف، فقبيلة أنف الناقة كانت تستحي من لقبها. ذكر ابن عبد ربه في كتابه؛ العقد الفريد هذه القصة، فقال: كان بنو حنظلة بن قريع بن عوف بن كعب يُقال لهم، أنف الناقة، وكانوا يسُبون بهذا الاسم في الجاهلية، والسبب في ذلك، أنّ أباهم نحر جزورًا وقسمَّ اللحم، فجاء ابنه حنظلة وقد فرغ اللحم و بقي الرأس، وكان صبيًا، فجعل يجرّه من أنفه؛ فقيل له: ما هذا؟ فقال: أنف الناقة. فلقُبِ به، وكانوا يغضبون من هذا اللقب، فلجأوا إلى الحطيئة ليمتدحهم حتى يتخلّصوا من هذا العيب: قَوْمٌ هُمُ الأَنـْفُ، والأَذْنابُ غَيْرُهُمُ
ومَنْ يُسَوِّي بأَنـْفِ الناقةِ الذَّنَبا؟
إنّ ازدواجية المعنى الذي يحمله الأنف يأتي من خطورة التعامل معه، فالجمل عندما لا يستجيب لصاحبه يشده من حلقة موضوعة في أنفه، فيخضع مباشرة. وفي الوقت نفسه نرى الأنفة والرفض عادة ما تكون برفع الذقن إلى الأعلى، فيأتي تعبير شم الأنوف مناسبًا لهؤلاء الذين لا يروضون أو يقادون حيث أنوفهم عصية على الزمام.
إنّ جدع الأنف يعني النفي، فمن طبقت عليه هذه العقوبة، لم يعد من أصحاب الأنوف الحرّة ولا من يرجى منهم الانقياد والطاعة، بالتالي يصبح خارج المجتمع الإنساني. ولن ينطبق عليه مقولة: مات حتف أنفه؛ والتي كانت تعني بأنّ الروح تخرج من حيث مقتلها، فإن أصيب في عنقه أو ظهره خرجت من مكان الإصابة، وإن مات الإنسان ميتة طبيعية خرجت روحه من أنفه، فهذه العقوبة تقصيه حتى عن الموت بشكل طبيعي.
الأكاذيب التي أنفها طويل:
إنّ ما قدمناه أعلاه يكشف لنا المعاني المضمرة للأنف بحيث لا تتكشف الدلالات الحقيقية لبعض القصص التي كان موضوعها الحكائي عن الأنف. تعتبر مغامرات بينوكيو من أشهر ما كتبه الأديب الإيطالي كارلو كلودي، وفيها ينسج قصة على منوال قصة آدم. لقد ولد بينوكيو بلا أب وأم، إلا أنه مصنوع من خشب على يد النجار جيبيتو، وليس من طين. يتمرد بينوكيو على خالقه النجار الذي كان له بمثابة الأب. ومن ثمّ يخوض مغامرات كثيرة، تقف بجانبه جنية تكافئه أخيرًا بأن تحوّله إلى إنسان بعد أن تتحقق من طيبة قلبه. يتميز بينوكيو بأنه يملك أنفًا يطول عندما يكذب. وقد اكتشف بينوكيو هذه الحقيقة عندما رأى الجنية تضحك من كذباته، فسألها بينوكيو كيف علمت بأنه كاذب، فأخبرته أن السبب هو أنفه الذي ما فتئ يزداد طولًا. ومن ثم أعلمته بوجود نوعين من الكذب: الكذب الذي حبله قصير، والكذب الذي أنفه طويل وأن كذبه من النوع الأخير. ربما يعود الشكل الخاص الذي يتجلى به كذب بينوكيو إلى أنّه في الأصل شجرة، ومن المعلوم لدى المشتغلين في الزراعة بأنّ تقليم الشجرة يزيد من إثمارها، ولا تصبح كشجرة التين التي لعنها المسيح لأنّه لم يجد فيها ثمارًا بل أعضان خضراء متطاولة. تحوّل بينوكيو إلى إنسان بسبب صلاحه الذي ظهر من خلال أنفه، لكنّه لو كذب ثانية، فلن يطول أنفه هذه المرة بل سيكون حبل المشنقة القصير بانتظاره.
لم يغب عن الروائي الروسي غوغول أن يستخدم الأنف في أحد قصصه مضمنًا إياها الكثير من الرموز. يستيقظ الضابط كوفاليوف ليجد وجهه من دون أنف، فتبدأ مطاردة الضابط لأنفه لإعادته إلى وجهه. يهتم الضابط كثيرًا بمنظره وخاصة بعد أن سنّ بطرس الأكبر قانونًا بمنح رتب اجتماعية تورث للعائلة جراء الخدمة في الدولة، وهذا ما سمح للكثيرين ممن لا يستحقون هذه الرتب أن ينالوها بسبب الفساد والرشاوي.
يعيش أنف كوفاليوف حياته الخاصة حتى أنه يصبح مستشارًا في الحكومة بموجب قانون بطرس. قبل أن يعرف الضابط كوفاليوف بفقدان أنفه، كان حلاقه يهم بتناول رغيف الخبز الذي أعدته له زوجته، لكنه يجد فيه أنف كوفاليوف. تطلب الزوجة منه أن يتخلص من هذا الأنف عبر رميه في النهر وكأنّها بذلك ترفض مرسوم بطرس الأكبر الذي جعل من لايستحق ينال الرتب الاجتماعية المميزة. يحاول الحلاق أن يرمي الأنف في النهر، إلا أن أحد رجال الشرطة يمنعه من ذلك. تنتهي القصة بعودة الأنف إلى كوفاليوف ويحلق له صديقه الحلاق لحيته. لاريب أن غوغول ينتقد العادات الجديدة في المجتمع، والتي تعتمد على المظهر وتغفل المضمون . إن عودة الأنف إلى وجه كوفاليوف هو إعادة تقييم لحاسة الشم التي أغفلت لصالح حاستي البصر والسمع.
الملاحة في الأنف:
هذه مقولة عربية، ترى بأنّ بيضة القبان في جمال الوجه هو الأنف، حيث نجد لها الآن تطبيقا كبيرًا في عمليات التجميل. لكن مع هذا الاهتمام الكبير بالأنف جماليّا في عصرنا، إلّا أنّه لم يعد للأنف دلالاته السابقة ويكاد أن ينحصر معنى الأنف في أنف المهرج الأحمر أو الأنف المكسور للملاكم. تقوم رياضة اليوغا على التنفس تارة من الفتحة اليمنى لتفعيل فصّ الدماغ الأيسر، وتارة أخرى من الفتحة اليسرى لتنشيط فصّ الدماغ الأيمن، لكن بعد أن يتقن تلميذ اليوغا فنّ التنفس يهمل الأنف، كما يحدث في الواقع حيث لا نهتم للأنف إلا عندما نصاب بالزكام. هكذا تم استبعاد الأنف من النيرفانا.
هل علينا أن نرثي الأنف الذي قاد الإنسان من الكهف إلى حضارته، وذلك عندما كانت الرائحة حدًا فاصلًا بين الموت والحياة، أم نمدح زمن الميتافيرس القادم الذي سيظل صناعيّا مهما رأينا وسمعنا داخله، ما لم تنقذه الحواس الدنيا من ذوق ولمس بقيادة ملّاح سفينة الواقع الأنف الأشم. مهما يكن من أمر الأنف في حضارتنا، سيظل الجبل الذي ارتفع فوق ماء الوجه، كما في أسطورة الخلق حيث ظهر الجبل من ماء العماء البدئي.
باسم سليمان
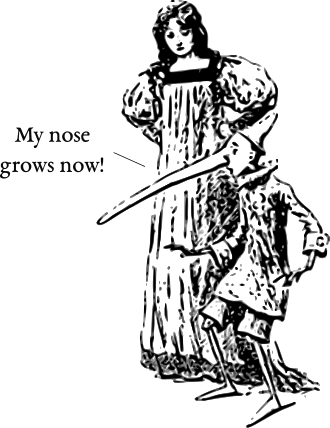
August 4, 2022
عن أنسنة الحيوانات وعن ضميرنا الذي أضعناه- باسم سليمان
مقالي في ضفة ثالثة اب ٢٠٢٢
(الحمار ضميرنا الذي أضعناه)
لقد دجّناه وألبسناه طبائعنا، فكان مهرّج البلاط الإنساني، نهزأ من حماقته، والأحرى أنّنا نضحك من أنفسنا، لكنّنا لا نجرؤ على الاعتراف بأنّنا الحمار الذي لبس جلد ملك الغابة في أمثولة إيسوب، وعندما رأى الخوف في عيني مالكه، أراد أن يعبّر عن فرحته، فنهق ولم يزأر. أراد الفيلسوف جان بورديان في القرن الرابع عشر أن يناقش مفهوم حرية الإرادة، فلم يجد أمامه متطوعًا غير الحمار. تقوم مجادلة بورديان على أنّه لو وضع حمار جائع وعطش في منتصف مسافة بين سطل ماء وكومة من التبن، واستوت دوافع العطش والجوع لديه، فلن يكون قادرًا على اتخاذ قرار عقلانيّ وحرّ، لأنّه لا يمكن له أن يتخذ قرارين عقلانيين متضادّين ومنطقيين في الوقت نفسه، كأن يختار الماء والتبن سواء بسواء. ولأنّ استواء الدوافع يمنعه من الحسم، سيظل الحمار حائرًا، وسيموت من العطش والجوع. هذه هي مفارقة الحمار والتي تعرف بالمقولة: تفلسف الحمار، فمات من الجوع والعطش، والتي كانت تناقش حرّية الإرادة. لكن العلم يقول غير ذلك، فالحمار الجائع والعطش بشكل متوسّط سيأكل أولًا، ومن ثم يروي عطشه، وإذا كان جوعه وعطشه كبيران، سيشرب أولًا، ومن ثم يأكل، فالحمار وفق فلسفته الخاصة لن يموت! هكذا يرفس الحمار بحافر واحد كل الجدل الفلسفي عن حرّية الاختيار التي أصبح الإنسان يتغنّى بها.
ترجع أنسنة الحيوانات في ثقافات الشعوب إلى فجر البشرية، هذه الأنسنة التشاكلية مع الوجود، لعب التشبيه الدور الأكبر فيها، فهو الاستقراء العلمي الأول للإنسان والتجريدي في الوقت نفسه. وعندما أدرك الإنسان أنّه كائن خُلق ليعمل، أبان ذلك عبر أساطيره، فكان الحمار الكائن الأنسب ليسقط معاناته وطبائعه وحالاته النفسية عليه، عبر أمثلة تهكمية مضلّلة، تظهر عكس ما تبطن.
إنّ الحمار حيوان خُلق ليعمل، فهو أول قنٌّ اتخذ منذ أن دجّن الإنسان الحيوانات الأخرى لتكون شريكته في مزرعته. ليس غريبًا أن ينصّ قانون حمورابي على غرامات مضاعفة على كل من يقتل حمارًا، وأن تنصّ التوراة على التضحية ببكور الحيوانات، واستثنت البكور من ولد الحمير. فعلى الرغم من ازدرائها للحمير وتبخيسها لتصبح شتيمة، لم تجد بدًا من أن يتم التضحية بالخرفان بدلًا من بكور الحمير. وعندما لا توجد إمكانية للتضحية بالخرفان، تكسر رقبة الحمار البكر كي لا تسفح قطرة دم واحدة منه، وكأنّ الإنسان عبر هذا الإسقاط التشخيصي من ذاته على الحمار دفعه إلى هذا الاستثناء.
قلنا عن علاقة الإنسان بالحمار بأنّها تقوم على أمثلة تهكمية مضلّلة. وحتى يتضح لنا ذلك لنذكر بعضًا من تفاصيل أسطورة برومثيوس(1). بعدما قيّد برومثيوس إلى جبال القوقاز وسلّط عليه نسر ينهش كبده كل يوم، خرجت من دمائه والصديد النازف من جروحه نبتة تعتبر تعزيمة تبعد الشيخوخة عن الإنسان وتجعله يتمتع بشباب دائم. وقد كانت هذه النبتة هدية زيوس للبشر الذين وشوا ببرومثيوس وأخبروه بأنّ برومثيوس هو من منحهم النار. وعندما عاد هؤلاء الواشون حملوا تلك النبتة على ظهر حمار وكان ذلك في يوم قائظ، ولأنّ الحمار كان عطشًا جدًا، فقد اندفع نحو الماء، لكنّ حيّة كانت تحرسه منعت الحمار من الاقتراب مالم يقايضها، بأن يعطيها النبات المانح للشباب مقابل أن تسمح له بالشرب وهذا ماحدث. لقد خسر البشر الخلود بسبب تهاون الحمار بالأمانة التي على ظهره، لكن لنقف قليلًا، فالحمار لن يُطعم من تلك النبتة، فلماذا عليه أن يعاني العطش لأجل حفنة من الواشين سلّموا برومثيوس إلى زيوس، وهو من منحهم النار الحلقة الأولى في حضارة الإنسان. من هنا جاء نعت الحمار بالغباء لدى الإغريق. هل حقًا كان غباء أم تغابيًا أم خطّ رجعة يستسمحون به من برومثيوس المشهور عنه أنّه كان المارد الذي أحب الإنسان، حتى أنّه حذر أخاه من أن يقع تحت غواية بندورا، هدية آلهة الأولمب له، لأنّها دومًا ماكرة. أصبح نعت الغباء لصيقًا بالحمار بعد تلك الواقعة، لكنّه لم يُكره ويعادَ ويقتل كما حدث مع الأفعى التي كانت سببًا في خسارة جلجامش الخلود وإهباط آدم من الجنة. إنّ تبصّرًا يكشف لنا بأنّ خلودًا، كما كان حال خيرون؛ الحكيم السنطور الذي له جسد حصان وجذع ورأس إنسان متأبدًا في ألمه، بعد أن جُرح بسهم أطلقه هرقل، لن يكون مناسبًا للإنسان الذي لن يأمن أن يصيبه جرح، وليس منيعًا ضد الآفات كما الآلهة الحقّة. إنّ هذا الخلود الهشّ الذي كان من الممكن أن تمنحه تلك النبتة للإنسان، أسوأ ألف مرّة من حياة الإنسان الفانية. لقد أنقذ الحمار بتهاونه الإنسان من خلود، هو العذاب بعينه، فلنقل أنّه غبيّ كي نحمه من بطش آلهة الأولمب.
يحكى(2) أنّه عندما جاء دور الحمار ليدخل إلى سفينة نوح تعلّق الشيطان بذيله يشدّه إلى الخارج، فيما النبي نوح يجذبه إلى داخل السفينة وعندما عيل صبر النبي، قال له: ادخلْ أيّها اللعين. هنا دخل الحمار، ودخل الشيطان واختبأ في زوايا السفينة، لكن نوحًا وجده، فقال له: من أدخلك السفينة، قال الشيطان: أنت! فقال له كيف، فقال: ألم تقل، ادخل يا لعين.
في هاتين القصتين يكون الحمار القناع الذي تختفي وراءه هواجس الإنسان، حيث الرمزية في تألّقها الأعظم.
الحمار الذهبي(3):
يشار دومًا إلى أنّ فنّ الرواية نشأ من القلق الوجودي الذي اعترى الكائن البشري بعد تهدّم الأنساق الكلاسيكية الكبرى وخاصة الدين، فأضحى متشظيّا في عالم يتقاسمه التقييد والفوضى، وتضاد المدينة والريف، وعالمية فجّة مقابل محلية آفلة. لم يكن عالم الرواية الحديث يفترق عن العالم الذي وجد لوكيوس أبوليوس نفسه فيه، فهذه الكوزموبوليتية التي أنشأها الإسكندر الكبير وأورثها للإمبراطورية الرومانية شظّت الانتماءات السابقة الضيّقة، فبدأ البحث عن منابع جديدة توفّر تأقلمًا مع هذا الوجود الجديد، الذي ولد من العالم القديم، حيث كان الإنسان متنعمًا في جنّة محيطه الضيق. تبدأ الرواية بهرب لوشيوس والذي يعني الحمار مع صديقته من المدينة عبر دواء سحري يحوّلهما إلى بومتين، لكن صديقته تخطئ وتعطيه عقارًا سحريّا آخر يحوّله إلى حمار، وهنا تبدأ رحلة لوشيوس بجسد حمار وعقل إنسان يخوض مغامرات متطرّفة، لكنّه في النهاية يعود إنسانًا، بعد أن يتآلف جسده وعقله بمساعدة الإلهة إيزيس.
اعتبرت البومة في التاريخ رمزًا للحكمة، وما سعي لوشيوس لأن يتحوّل إلى بومة إلّا لكي يواجه بالحكمة فوضى هذا العالم، إلّا أنّه تحوّل إلى حمار؛ الرمز الحقيقي الفلسفي للإنسان الذي وضعت فيه كل ثنائيات الكون المتناقضة، وطلب منه أن يسوس نفسه في ظلّ شقاء لا ينتهي من ولادته إلى موته، فكان الأنسب له أن يغدو حمارًا، فحكمة البومة مفارقة لهذا العالم، في حين تجربة الحمار محايثة له وتنتج حكمة عملية لا تنظيرية. حدث ذلك كلّه للوشيوس في ثنايا عالم انفتح عن آخرته، فالحكمة اليونانية المتمثّلة بالفلسفة، لم تعد قادرة على إنقاذه، لذلك كان لابدّ من عبادة جديدة تتمظهر بإلهة لها مميزات تستوعب هذه الكوزموبوليتية، وتقبل تعارض الثنائيات في الهوية، فكانت إيزيس. هذه الديانة الغنوصية الحدسية التي لا تستبعد اللاوعي من ساحة الشعور، وتستند إلى الانفعالات وإطلاق المشاعر. فهي لا تختلف كثيرًا عن عبادة دينيسيوس والتي صورّها يوريبيدوس في مسرحيته عابدات باخوس في زمن هزيمة أثينا كما شرحها تيري إيغلتون(4) فالحكمة الفلسفية المحلية لم تعد تجيب على تناقضات الوجود، فهناك آخر له من المشروعية الوجودية كما للذات المرتحلة في هذا العالم، فالعقل لايقوم من دون غريزة، والغريزة فوضى من دون عقل. لم تكن نجاة لوشيوس إلّا بعد أن جمع بين الاثنين في إلفة وتعارض، لكن في وئام قلق. هكذا يعود إنسانًا بعد أن تحوّل إلى حمار؛ أكثر الحيوانات التي تكرهها إيزيس، يا للعجب!
كان الحكيم إيسوب قد استخدم ثيمة الحمار في الكثير من أقاصيصه. ولعلّ أشهرها قصة الحمار الذي يرتدي جلد الأسد. كان إيسوب عبدًا محرّرًا دميمًا، فهل كان يقصد أنّه يشبه ذلك الحمار بأقصوصته؟ ليس مهمًا أن نجيب، فالعبرة من الأقصوصة أن تكون أنت، وما تظنّه بجلد الأسد من مهابة، ما هو إلّا خداع، فالأسد ليس في جلده، بل في شيء آخر تمًامًا، وهو ذاته التي إن خرج عنها، لا تنفعه ألف لبدة تحيط بعنقه.
كانت كليلة ودمنة لابن المقفع مثالًا عن مسرحة حياة الإنسان بشكل حيواني لاستخلاص العبر. ففي حكاية الأسد والحمار، نرى ملك الغابة مريضًا ولن يشفى إلّا بقلب وأذني حمار. إنّه دواء غريب لجأ إليه ملك الغابة، فليس من جاهل إلّا ويعرف مقدار عماء قلب الحمار وأن أذنيه لا تصلحان إلا لكشّ الذباب، لا للسماع! وكأنّ ابن المقفع يقول هذه حال سلطات الحكم، فبدلًا من الكحل تختار العماء. لذلك كان جواب ابن آوى لملك الغابة الذي تفاجأ بأنّ الحمار ليس له قلب ولا أذنان، فالحمار الهارب من استغلال صاحب المطحنة، لو كان له قلب يعي وأذنان تسمعان لما رجع إليك يا ملك السباع، بعد أن نجا منك أول مرّة. والأحرى أنّه كان يقول: لو كنت يا ملك الغابة بقلب يعي وأذنان تسمعان لما وصل حالك إلى هذا الدرك الأسفل.
يحضر الحمار كناصح في ألف ليلة وليلة، عبر تمثّل يريد فيه الوزير أن يقنع ابنته بالتراجع عن الزواج من شهريار، فيحكي لها قصة الحمار الذي نصح الثور كيف يتحايل على صاحب المزرعة كي يرفع عنه أعباء الأعمال المنوطة به. تجدي نصائح الحمار للثور ويضع عنه صاحبه نير العمل، لكنّه يزج بالحمار بدلًا عن الثور في تلك الأعمال القاسية. وأنت يا شهرزاد تشبهين هذا الحمار! هل حقًّا هذا ما قصده الوزير أم أنّه أضمر عبر هذه القصة مقدار تخاذله عن نصيحة الملك شهريار، أليس هو وزيره ومستشاره ومن واجبه أن يقوم بدور الناصح، مهما كانت العواقب؟ والأكثر غورًا في قصته أنّه لا يريد أن تكون ابنته متخاذلة عن النصيحة مثله، وإلّا لماذا استكمل محاججته بإقناع ابنته بأن قصّ لها حكاية الديك ودجاجاته الخمسين وقدرته على سوسهن بإرضاء هذه وإغضاب تلك، بعد قصة الحمار والثور. ألم تصبح شهرزاد تشبه الديك، ترضي الملك بقصة وتعلّق قلبه بقصة أخرى؟
من حمار جحا إلى بنيامين:
لا يمكن أن يكون جحا راكبًا لجمل أو حصان، لأنّ الفكاهة ستموت، فراكبو الجمال والأحصنة جادون جدًا! هكذا كان الحمار هو رفيق دربه أو قناعه الذي يتهكّم به على العادات والتقاليد ويهجو به السلطات وهي تضحك عليه، لكن ضمنًا على نفسها. هذه الرمزية للحمار التقطها سرفانتس وأركب سانشو حمارًا يدعى دابل، لا فرق عمليّا بينهما، فعندما ينعت سانشو حماره يقول عنه: ابن أحشائه، وفرحة أولاده، وغبطة زوجته، وأنّه يكسب من المال مايزيد عن علفه وكأنّه يصف نفسه. يقف دابل وسانشو في مواجهة دون كيشوت وحصانه روزنناتي الذي يعني اسمه في الإسبانية(5): الحصان الذي كان عاديًا. لقد كان دون كيشوت إنسانًا عاديّا قبل أن تلحس عقله روايات الفروسية، أو أوهام المُثل، ويحوّل حصانًا أعجف، أشبه بالعصر الذي كان فيه، إلى حصان يخوض المعارك مع مردة الطواحين، هكذا انتقم سرفانتس من راكبي الأحصنة وما يمثلوه. يؤكّد سرفانتس على هذه المفارقة حتى في اللحظات التي يشطح بها عقل سانشو بانزا ويحلم بمملكة تخصّه، فإنّه لا يغادر الواقع. في كلتا الحالتين نرى حمار جحا وحمار سانشو كواقعين يركبهما ساخران كبيران.
لم ينسب جورج أورويل حماره بنيامين في روايته مزرعة الحيوانات إلى أحد حمير الثقافة العالمية، لكن بالتأكيد لا ينتسب بنيامين إلى حمار جحا ولا إلى دابل. فحمار أورويل جده يُدعى صابر. وقد خلّده فيكتور هيغو في قصيدة طويلة يحاور الحمار فيها كانط أكبر الفلاسفة الأخلاقيين في أوروبا وينتصر عليه، ويعلن هيغو بأنّ الحمار صابر أفضل من أرسطو وأفلاطون. لقد بدأت النزعة التشاؤمية تكبر وتتجذّر في العصور الحديثة مع تلاشي وعود عصر النهضة والتنوير بإقامة مجد الإنسانية. لم يكن بنيامين إلّا شوبنهاور مزرعة الحيوانات. لقد كان تشاؤميّا بشكل كبير، فماذا يفعل بذكائه وقدرته على القراءة، وهو يرى الخنازير ترث الإنسان الذي أذاقهم الويلات، فلم تكن الخنازير أقل قدرة من الإنسان على سفك دماء أخوتها من الحيوانات لأجل مصالحها الخاصة. قيل عن رمزية بنيامين الكثير من أنّه يمثل المثقفين الذين صمتوا عن ديكتاتورية ستالين، لكنّ الحمار بنيامين كان متأكّدًا أنّه لاجدوى، وأنّ عصر الإنسان الذي بلا معنى قد حلّ، كذلك عصر الحيوان الذي بلا معنى. هكذا تخلّى بنيامين عن إرث الحمير الساخر التهكمي، لكنّه أراد أن يذكّرنا للحظة بطبيعة الحمير الساخرة، عندما همّ بمساعدة صديقه الحصان، لكن بعد فوات الأوان، ولم يبق بيده من فكاهة إلّا السخرية من نفسه ومن تاريخ الحمير، لأول مرّة، هكذا أعلن بنيامين هزيمة الإنسان والحمير أمام عقم التاريخ الذي ينتقل من مأساة إلى مهزلة وفق تعبير ماركس.
نسق الحمار ونسق الإنسان:
تكلّم فلاديمير بروب عن الأنساق الحكائية المتكرّرة في تاريخ الإنسان. ونستطيع استنادًا إلى بروب أن نقول بأنّ ماذكرناه أعلاه مجرد إضاءة على النسق الحكائي للحمار الذي اشتكل وتجادل مع النسق الحكائي للإنسان. فمن هوميروس والديانات السماوية وشكسبير وتوفيق الحكيم وخوان رولفو وآخرين كثر، إلى السياسة وحزب الحمير، حضر الحمار كشخصية أساسية في الثقافة الإنسانية، لكنّ الحمار يواجه الانقراض، ليس بيولوجيّا فقط، بل جماليّا، فحمار الأدب أصبح أكثر تأنسنًا وهذا يضعفه جماليًّا، فالمكر الحكائي الذي رأيناه مع لوكيوس أبوليوس ودابل قد ضعف كثيرًا، فلم يعد حمار الأدب ينهق في سرديات الأدب الحديث كما برهن بنيامين. وقبل أن نختم هذه السيرة المختصرة لأدبيات الحمير في الثقافة الإنسانية لابدّ من القول، بأنّ الأنسنة يجب أن لا تُفقد الأشياء والحيوانات طبيعتها، لأنّه قد يأتي يوم لا نجد فيه حمارًا يحذّرنا من أنفسنا، فالأسطورة تقول بأنّ الحمار ينهق عندما يرى شيطانًا.
المصادر:
1- أسطورة برومثيوس في الأدبين الإنكليزي والفرنسي – لويس عوض – المركز القومي للترجمة – مصر، الطبعة الثانية 2009.
2- الكامل في التاريخ، ابن الأثير، دار الكتب العلمية 1987.
3- الحمار الذهبي، لوكيوس أبوليوس. ترجمة: د. أبو العيد دودو – منشورات ضفاف والاختلاف- بيروت 2004.
4- الإرهاب المقدس، تيري إيغلتون. ترجمة أسامة أسبر، بداية للنشر -سورية 2007.
خاص ضفة ثالثة
 https://diffah.alaraby.co.uk/diffah/civilisation/2022/8/4/%D8%B9%D9-%D8%A3%D9%D8%B3%D9%D8%A9-%D8%A7%D9%D8%AD%D9%8A%D9%D8%A7%D9%D8%A7%D8%AA-%D9%D8%B9%D9-%D8%B6%D9%D9%8A%D8%B1%D9%D8%A7-%D8%A7%D9%D8%B0%D9%8A-%D8%A3%D8%B6%D8%B9%D9%D8%A7%D9?fbclid=IwAR2lVaUR-XXdDBZpxJz7rUp00DmMTB1aIsRxKW887rrco6Ivr7MObAtDKf4
https://diffah.alaraby.co.uk/diffah/civilisation/2022/8/4/%D8%B9%D9-%D8%A3%D9%D8%B3%D9%D8%A9-%D8%A7%D9%D8%AD%D9%8A%D9%D8%A7%D9%D8%A7%D8%AA-%D9%D8%B9%D9-%D8%B6%D9%D9%8A%D8%B1%D9%D8%A7-%D8%A7%D9%D8%B0%D9%8A-%D8%A3%D8%B6%D8%B9%D9%D8%A7%D9?fbclid=IwAR2lVaUR-XXdDBZpxJz7rUp00DmMTB1aIsRxKW887rrco6Ivr7MObAtDKf4
August 1, 2022
الأنثى الغلامية… مذكّرة مؤنّثة يحار فيها البصر – باسم سليمان
مقالي في مجلة نقد 21 المصرية العدد التاسع/ أب 2022
هذا العنوان مختصر لمَا ذكره علي بن الجهم في خبر إحدى الجواري، كما جاء لدى ابن عبد ربه(1). وهذه الجارية من المتشبّهات بالذكور، ولكي تزيد شبهها بالذكور تقلّدت سيفًا وعلى رأسها قلنسوة مكتوب عليها:
تأمّل حسن جارية/ يحار فيها البصر
مذكّرة مؤنّثة/ فهي أنثى وهي ذكر.
ليست الإناث المتشبِّهات بالذكور، أو الغلاميات مجرد بدعة انتشرت في الزمن العباسي، بل هي ظاهرة ملحوظة في المجتمع العربي القديم. وعندما تتهيأ لها بعض الظروف الاجتماعية، فإنّنا نراها تتواجد في العلن. وهكذا أصبحت ظاهرة لها شأنها في القصور العباسية، فقد كانت الظروف الاجتماعية مناسبة؛ وخاصة أنّ الخليفة المتوكّل وغيره من الخلفاء كانوا شغوفين بالغلاميات. تزوّج المتوكّل ريطة بنت العباس بن علي كما ذكر الجاحظ (2)، بعدما وصفت له، فسألها أن تطمّ شعرها، أي أن تقصّه قصة ذكوريّة، فرفضت، فأعلمها إن لم تفعل ذلك فارقها، فاختارت الفرقة، فطلقها.
عرف العرب في جاهليتهم بعضًا من الإناث المتشبِّهات بالذكور، اللواتي جاهرن بذلك، ولربما يعود ذلك إلى تطلّعهن إلى الحقوق الممنوحة للذكور من صيد وركوب خيل، فكان تشبههن بالذكور؛ وخاصة الثياب وسيلة لنيل بعض الحقوق التي منعها عنهن المجتمع.
تناثرت أخبار الغلاميات في التاريخ العربي. ومن ذكر خبرًا يفيدنا بهذا الخصوص عمر بن أبي ربيعة عن صديقه الجعد بن مهجع من قبيلة عذرة الذي تيمته غلامية صادفها في أرض قبيلة كلب. كان الجعد يستريح في فيء شجرة: “وإذ بغلام يطارد حمارًا وحشيّا وأتانه، فتأملته، فإذا عليه درع أصفر وعمامة خزّ أسود. وإذا فروع شعره تضرب خصريه، فقلت: غلام حديث عهد بعرس، أعجلته لذّة الصيد، فترك ثوبه، ولبس ثوب امرأته، فما جاز علي قليلًا حتى طعن المسحل/ حمار الوحش، وثنى طعنة للأتان”.
تدور رحى الحكاية ويتكشّف للجعد بأنّ الفتى أنثى؛ لها ثدي كالعاج، فتقع في نفسه، ويغرم بها مع أنّها نادمته الخمر والحديث. ومن ثمّ تنتهي القصة بالزواج. لقد كانت هذه الأنثى تتشبّه بالذكور من أجل الصيد والشراب، أي ما يختصّ به الذكور في تلك الأزمنة.
تتابع الأخبار عن تلك الغلاميات، فقد جاء في كتاب الكبائر، بأنّ المغنيّة عزّة الميلاء كانت تتشبّه بالذكور، وتلبس لباسهم. وقد سمّيت الميلاء نسبة إلى الثوب الذي يلبسه الذكر ويسمى الملاء. وممن ذكر التاريخ أخبارهن كانت الزوجة الثالثة للشاعر الضحاك الذي استمع لنصيحة الحجاج، بأنّ الرجل لا يهنأ إلّا إذا تزوّج بأربع حرائر، لكن الشاعر الضحّاك لم يوفق بزوجاته، فوصفهن مستهجنًا حالهن، وكانت زوجته الثالثة غلامية متشبّهة بالذكور:
وثالثة ما إن تُوراى بثوبها/ مذكّرة مشهورة بالتبرّج.
لم تتخذ الغلاميات في العصر الأموي شكلًا مميزًا واحدًا، بحيث نقع على نمط من الممكن دراسة علاماته بوضوح، لكن مع الزمن العباسي أصبحت الأمور جلّية، حيث كانت الغلاميات قد وعين تمامًا لمقاصدهن من التشبّه بالذكور. وقد يكون بيت المعلّي الطائي، كما جاء في طبقات الشعراء لابن المعتز، ما يؤكّد أن تشبه تلك الإناث بزي الرجال كان هدفه التمرد على واقعهن: تقمَّص أثواب الرجال تمردًا وتأنف من لبس القلادة والشنف.
وقبل أن ندخل في جلاء وضع الغلاميات في تراثنا العربي، سنستعين بإحدى قصائد أبي نواس كمشهد بانورامي نستجلي من خلاله مميزات وصفات الغلاميات: وَشاطِرَةٍ تَتيهُ بِحُسنِ وَجهٍ كَضَوءِ البَرقِ في جُنحِ الظَلامِ
رَأَت زِيَّ الغُلامِ أَتَمَّ حُسناً وَأَدنى لِلفُسوقِ وَلِلأَثامِ
فَما زالَت تُصَرِّفُ فيهِ حَتّى حَكَتهُ في الفِعالِ وَفي الكَلامِ
وَراحَت تَستَطيلُ عَلى الجَواري بِفَضلٍ في الشَطارَةِ وَالغَرامِ
تَعافُ الدَفَّ تَكريهاً وَفَتكاً وَتَلعَبُ لِلمَجانَةِ بِالحَمامِ
وَيَدعوها إِلى الطُنبورِ حِذقٌ إِذا دارَت مُعَتَّقَةُ المُدامِ
وَتَغدو لِلصَوالِجِ كُلَّ يَومٍ وَتَرمي بِالبَنادِقِ وَالسِهامِ
تُرَجِّلُ شَعرَها وَتُطيلُ صُدغاً وَتَلوي كُمَّها فِعلَ الغُلامِ.
لكن قبل أن نلج عوالم تلك الغلاميات، لابدّ من الإشارة إلى أنّ الأخبار التي أوردناها أعلاه تشير إلى تواجد الغلاميات في المجتمع العربي القديم، لكنهن لم يكنّ بالكثرة التي ظهرن بها في العصر العباسي وما بعده. وإذا استجلينا بعض الأخبارـ وقاطعناها مع ما فعلته زبيدة زوجة الرشيد بجواري ابنها الأمين، قد نصل إلى شبهة تاريخ في ظهور الغلاميات. وممّا حكاه الجاحظ، بأنّ أبا مسلم الخرساني منع النساء من مصاحبة الجنود في معسكراتهم وسنّ لهم أن يتولى خدمتهم الغلمان لخفة مؤونتهم وسهولة حركتهم. وطالت صحبة الغلمان للعسكر ففتنوا بهم. وفي خبر جاء عن أبي نواس يفسّر فيه مجونه وعشقه للغلمان والغلاميات بأنّه تعلّمه من أحمد بن إسحاق الخاركي الذي جاهر بذلك فتبعه القوم: “ما مجنت ولا خلعت العذار حتى عاشرت الخاركي، فجاهر بذلك ولم يحتشم، فامتثلنا نحن ما أتى به، وسلكنا مسلكه، ونحن ومن يذهب مذهبنا عيال عليه”. ولنا أن نفهم من خبر أبي نواس بأنّ الأمور قبل الخاركي كانت مكتومة. وإذا قاطعناها مع خبر الخليفة الثاني العباسي؛ المنصور الذي كان متشددًا باللباس، فقد عاقب أحد كتبته، لأنّ سراويله كانت من الكتان(3). وعلى ما يبدو أن ثياب الكتّان التي كان الكاتب يلبسها، كانت تشي بتفاصيل جسده. أمّا ابنه المهدي الذي استلم الخلافة بعده فلم يضره قول أبي العتاهية في مقدمة مديحه له وهو الذي أخرج للناس ابنته الغلامية البانوقة. قال أبو العتاهية: أَلا إِنَّ جارِيَةً لِلإِمـــــا/ مِ قَد أُسكِنَ الحُبُّ سِربالَها
مَشَت بَينَ حورٍ قِصارِ الخُطا/ تُجاذِبُ في المَشيِ أَكفالَها
وَقَد أَتعَبَ اللَهُ نَفسي بِها / وَأَتعَبَ بِاللَومِ عُذّالَها.
وعندما وصلت الأمور إلى الرشيد، الذي حوى قصره أكثر من أربع آلاف جارية، كان زيّ الغلاميات قد استقر واشتهر بين الناس. فالمأمون قد أحبّ الغلاميات. كما شغف ما تلاه من الخلفاء بهن. وقد أوردنا سابقًا خبر المتوكّل مع ريطة بنت العباس. وفي خبر أورده المسعودي في مروج الذهب عن الإخباري محمد بن علي الخراساني الذي طلب منه الخليفة القاهر أن يقصّ عليه أخبار زبيدة وابنها الأمين: “فاتخذ الناس من الخاصة والعامة الجواري المطمومات وألبسوهن الأقبية والمناطق، وسمّوهن الغلاميات” ونستنتج من هذا الخبر أنّ لقب الغلاميات قد استحدث في الزمن العباسي.
المظاهر الخارجية للغلاميات: لقد سعت الغلاميات للتشبّه بالذكور من خلال تقليدهن في زِيِّهِم وهَيْأَتِهِمُ الخاصَّةِ بهم وأخلاقِهِم وأفْعالِهم وأقْوالِهم، أو رفْعِ صَوتِهم، أو غيرِ ذلِك. ومن أكثر أوجه الشبه كان لبس الغلاميات للنعل، وذلك لأنّ النعل لم تكن تستر كلّ القدم، بل تترك بعض الساق مكشوفًا؛ ألهذا اختارت المتشبّهات بالذكور لبس النعل! وورد في الأغاني لأبي فرج، بأنّه كانت هناك بنت ليحيى بن الحكم بن أبي العاص تركب الفرس وتستبق مع صديقة لها تدعى أم سعيد الأسلمية وتستبقان حتى يبان مكان الخلخال من ساقيهما. أي أنّهما كانتا تلبسان النعل. ولقد طلب معاوية من مروان بن الحكم أن يتخلّص من بنت أخيه: “اكفني بنت أخيك، فقال: أفعل، فاستزارها وأمر ببئر فحفرت في طريقها وغطت بحصير، فلما مشت عليه سقطت في البئر، فكانت قبرها”.
إنّ السلطة المتمثّلة بمعاوية، هي التي عارضت بنت يحيى، فيما ذهبت إليه والدليل بأنّ يحيى بن الحكم كان راضيّا عن خروج ابنته عن الأعراف والتقاليد، وإلا كان قد منعها ابتداءً وهذا دليل على انتشار المتشبّهات بالذكور وتواتر وجودهن قبل أن تحكم السلطة قبضتها على العادات والتقاليد.
ومما ذكره ابن منظور في أخبار أبي نواس، أنّه مضى وصديقه إلى باب أسماء بنت المهدي حيث كان الشعراء يجتمعون في مجلس، فخرجت عليهم إحدى جواريها. وما يهمنا الآن في هذا الخبر، بأنّها كانت تنتعل حذاء تشبّهًا بالذكور: “وفي رجليها نعل مغشّاة بديباج”.
لقد كانت المتشبّهات بالذكور يحرصن على لبس النعل أو الحذاء الذي اختص بها الرجال. وقد قال أبو نواس: مذكّرة الحذاء إذا استُهشت/ لأمر لا يثاقلها القيام. ويحمل هذا البيت الكثير من الدلالات التي تناقض الصفات المكرسة عن الأنثى، ففي اليتيمية يقول الشاعر: فَنهوضُهـــا مَثنىً إِذا نَهَضت/مِن ثِقلَهِ وَقُعودهـــــا فَردُ.
إنّ مقارنة الأنثى التي يصفها أبو نواس مع أنثى اليتيمية يوضّح الفرق، فالمتشبّهات بالذكور اللابسات النعال نشيطات محتفّزات للفعل والحركة.
لم تتوقّف الغلاميات عند الحذاء، بل ذهبن في محاكاة ألبسة الذكور كل المذاهب. ومما لحظ عليهن اقتداءهن بمظاهر الأكمام من اللباس، فمرّة ضيقة، ومرّة أخرى واسعة مرخية مسبلة.
ولقد جاء في حديث الذهبي، بأنّ لبس الأكمام الضيقة يعتبر تشبهًا بالذكور، لكن في العصر العباسي أصبح إرخاء الكم هو المطلوب، كما ذكر أبو نواس: “وَتَلوي كُمَّها فِعلَ الغُلامِ” وبهذا يشير ابن الساعاتي لتلك المحاكاة التي اتبعتها النساء: وكأنَّ غصن البان في أوراقهِ هيفاءُ خاطرةٌ بكمٍّ مسبل.
استبدلت المتشبِّهات بالذكور أثوابهن، وحاكين أثواب الرجال. يقول أبو نواس في وصف معشوق؛ جارية أسماء بنت المهدي:
مُقَرطَقَةٌ لَم يَحنِها سَحبُ ذَيلِها
وَلا نازَعَتها الريحُ فَضلَ البَنائِقِ
تُشارِكُ في الصُنعِ النِساءَ وَسُلّمَت
لَهُنَّ صُنوفُ الحُليِ غَيرَ المَناطِقِ
يضع أبو نواس بين أيدينا في هذه الأبيات ميزات لباس تلك الإناث؛ وخاصة لبس المقرطق والذي نستشف منه بناء على قوله بأنّ هذا اللباس غير ثقيل، ولا يقيّد الحركة، فلا ينحني ظهر الأنثى منه، ولا فيه من الزوائد ما تلعب به الريح، وكأنّه على قياس الجسد. والشيء الآخر الذي نجده في أبيات أبي نواس، بأنّ هذه الجارية طرحت عنها الحلي وأبقت على الحزام الذي تشدّه على خصرها كالرجال، وهي بذلك أصبحت أقرب للذكر من الأنثى:
تُشارِكُ في الصُنعِ النِساءَ وَسُلّمَت
لَهُنَّ صُنوفُ الحُليِ غَيرَ المَناطِقِ.
ولقد جاء في كتاب تاريخ الرسل والملوك بأنّ البانوقة ابنة الخليفة المهدي كانت تلبس المنطقة تشدّ بها خصرها، فيظهر نهود ثدييها تحت القباء/ الثوب ولقد روى الطبري : “رأيت المهدي يسير وعبد الله بن مالك على شرطه يسير أمامه في يده الحربة، وابنته البانوقة تسير بين يديه وبين صاحب الشرطة في هيئة الفتيان وعليها قباء أسود ومنطقة وشاش متقلّدة السيف. وأنّي لأرى نهود ثدييها قد رفعا القباء”. إنّ دراسة هذا النص يتيح لنا أن نعلم شكل الثوب الذي سمح لنهدي البانوقة بالظهور بأنّه ضيق، وزاد من ضيقه وملاصقته لجسدها المنطقة/ الحزام التي تشدها على خصرها. قال أبو نواس: غُلاميّـةٍ فـي زيّهـا برمكـيّـةٍ مناطقُها قد غبْنَ من لطُفِ الخصْـرِ.
إنّ البانوقة إحدى تلك الغلاميات، ففي مشيتها بين يدي أبيها وقائد شرطته متسلّحة بسيف تشدّ خصرها بحزام غير خجلة من نهود ثدييها، يشير إلينا بأنّ تلك الغلاميات لم يكن قد فارقن روحهن الأنثوية، لكن ما أردنه حقوقًا لا تؤخذ إلا بالتشبّه بالذكور. وهذا ما يؤكده أبو نواس:
غُلامٌ وَإِلّا فَالغُلامُ شَبيهُها
وَرَيحانُ دُنيا لَذَّةٌ لِلمُعانِقِ
تَجَمَّعَ فيها الشَكلُ وَالزَيُّ كُلَّهُ
فَلَيسَ يُوَفّي وَصفَها قَولُ ناطِقِ.
تبينّا في خبر الجعد بن درهم بأنّ الأنثى التي تيّمته كانت تعتمر عمامة بخزّ أسود. ولقد درجت هذه العادة بين المتشبهات بالذكور. وقد تقدّم وصف الجارية التي أتى على ذكرها علي بن الجهم من تقلّدها السيف ولبس القلنسوة. كذلك فعلت البانوقة ابنة المهدي ولقد اتخذت زبيدة زوجة الخليفة الرشيد الجواري الغلاميات لابنها الأمين عندما رأت شغفه بالخصيان والذكور، لربما تصرفه عنهم إذ أتت بإناث يشبهن الذكور. ويقول المسعودي في مروج الذهب: “اتخذت الجواري المقدودات الحسان الوجوه وعمّمت رؤوسهن وجعلت لهن الطرر والأصداغ والأقفية وألبستهم الأقبية والقراطق والمناطق، فلانت قدودهن وبرزت أردافهن”.
إنّ التشبه بالذكور يكاد لا يتم ما لم يتعد إلى الشعر وأحواله وفي الخبر عن الجعد بن مهجع ووصفه للفتى الذي أتضح أنّه أنثى متقنّعة بزيّ الذكور نجد أنّ فروع شعره كانت تضرب خصريه. أي أن تشبهها لا يتم إلّا إذا أطلقت شعرها كما يفعل الفتيان. يقول أبو نواس في وصف الغلامية:
ترجّل شعرها وتطيل صدغًا وترخي كمها فعل الغلام.
والذي يقصده أبو نواس بترجيل الشعر، أنّ الجارية كانت تتركه منسرحًا كشعر الغلام إمعانًا بالتشبّه، وترسل شعر صدغيها على وجنتيها. وفي وصف جارية أسماء ابنة المهدي التي تدعى معشوق يصف أبو نواس حال شعرها:
ومطمومة لم تتصل بذؤابة
ولم تعتقد بالتاج فوق المفارق
ومطمومة الشعر، أي التي قصته، كما يفعل الغلام ونرى في الشطر الثاني بأنّ تلك الجارية أنفت لبس التيجان وهنا نفهم ميل تلك الغلاميات إلى لبس القلنسوات والعمامات تشبهًا بالذكور. وفي خبر عن جبلة بن الأيهم عندما أرسل إلى هرقل قال، بأنّه رأى جاريات مطمومات الشعر في بلاط هرقل، كما جاء في العقد الفريد. وفي خبر أورده ابن المعتز: “قال بعض خلفاء بني أمية لرجل من جلسائه: ما يطيب في يومنا هذا؟ فقال: قهوة صفراء في زجاجة بيضاء تناولنيها مقدودة هيفاء مطمومة لنا”. ومن هذين الخبرين الأخيرين نرى أنّ عادة طمّ الشعر، أي قصّه للجّاريات كانت معروفة عند العرب قبل أن تنتشر في زمن العباسيين.
تفنّنت تلك الغلاميات باللعب بشعورهن، فأطلن السوالف حتى أنّهن خططن الشوارب بالمسك والألوان، يقول أبو النواس:
أصداغهن معقربات
والشوارب من عبير.
المظاهر النفسية للغلاميات:
يقول أبو نواس:
وَشاطِرَةٍ تَتيهُ بِحُسنِ وَجهٍ
كَضَوءِ البَرقِ في جُنحِ الظَلامِ
رَأَت زِيَّ الغُلامِ أَتَمَّ حُسناً
وَأَدنى لِلفُسوقِ وَلِلأثامِ.
من هي الشاطرة استنادًا إلى اللغة ومعجم رينهارت(4)؟ هي كل امرأة أعيت أهلها خبثًا وفتكًا وعرفت بالتهتّك والجرأة ولها زيّ خاص تمشي به مختالة مسبلة الكم، أي تلك التي تقلّد الشطار من الذكور في كلّ حركة وفكرة. ونتابع استجلاء قصيدة أبي نواس لنجد أن تلك الغلامية قد فاقت الجواري بسبب شطارتها وما تتغياه:
وَراحَت تَستَطيلُ عَلى الجَواري بِفَضلٍ في الشَطارَةِ وَالغَرامِ
بل إنّها تركت عزف الدفوف، لأنّ الضاربات بها كنّ عادة من النساء. وذهبت إلى عزف الطنبور لاختصاص الذكور بعزفه:
وَيَدعوها إِلى الطُنبورِ حِذقٌ إِذا دارَت مُعَتَّقَةُ المُدامِ.
ويتابع أبو نواس في وصف التغيّرات النفسية لتلك الشاطرة حتى أنّها تخرج للذكور منافسة إياهم: وَتَرمي بِالبَنادِقِ وَالسِهامِ.
تمعن الغلامية تقمصّها دور الغلام، فتذهب للتكريه، وهو عكس الدلال المشهور عن الإناث، فتظهر قساوة وسلاطة لسان: “تَعافُ الدَفَّ تَكريهاً وَفَتكاً” وهذا التكريه أو إظهار الجديّة والغضب، قد لحظه العديد من الشعراء، فيقول الضحّاك:
وشاطريِّ اللّسان مختلق التّ/كريه شاب المجون بالنُّسك.
ولابن الرومي بيت في ذلك التكريه:
ورقاصة بالطبل والصنج كـــاعب
لها غنجُ مخناث وتكريه فــــــــــاتك. ولنوضح مفهوم التكريه أكثر نورد بيت أبي نواس التالي:
أحب الغلام إذا كرّها….
وقد حذر الناس سكينه
فكلهم يتقي شرّها.
نستطيع أن نصل إلى نتيجة، بأن الغلامية تتقمّص نفسية الغلام بالتكريه، ورفض كل مظاهر رقّة النساء وضعفهن مع الحفاظ على سحر جمالهن إلى أقصى الحدود.
هل الغلاميات حركة نسوية؟
في الأخبار التي أوردناها أعلاه، من خبر الجاحظ عن الأسباب التي أدّت بالمجتمع لمحبة الغلمان، إلى خبر زبيدة الذي تم به إيضاح متى انتشرت العادة بين الناس في حبّ الفتيات الغلاميات، لكن ورود الأخبار من الجاهلية وما تلاها من أزمنة عن تواجد الغلاميات بالإضافة إلى الأحاديث عن كراهة ومنع تشبه النساء بالذكور تشير إلينا بأنّ النزعة الغلامية كانت متواجدة قبل ذلك بكثير، إلا أنّه لم تتفش إلا في العصر العباسي.
لا ريب بأنّ ظنونًا وشكوكًا ستقودنا إلى القول، بأنّ تلك الغلاميات كانت لهن أجساد إناث وأرواح ذكور، لكن لم تتواتر الأخبار على ذلك. لقد كنّ إناثًا بأرواح أنثوية تتوق إلى الحرية واقتناص ما يناله الذكر من حقوق عن طريق الشطارة وتقمّص أخلاقيات الغلمان.
وهنا، هل لنا أن نشطح قليلًا، ونقول عن الغلاميات، بأنّهن حركة نسوية وفق ظروف عصرهن! ليست الإجابة من السهولة بمكان، إلا أنّ هذا الشطح يدفعنا أكثر للتعمّق في دراسة تراثنا العربي، وكشف ما أخفته السلطات من روايات تناقض ما أقرته من سرديات نعتبرها اليقين بذاته!.
المصادر:
1- العقد الفريد، الجزء الرابع. الناشر: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر- القاهرة 1940.
2- المحاسن والأضداد، الجاحظ، طبع في ليدن 1898.
3- كتاب الوزراء والكتاب، الجهشياري. الناشر دار الصاوي – القاهرة 1938.
4- تكملة معاجم اللغة، رينهارت. الناشر دار الرشيد.
ملاحظة: أكثر الأبيات التي وردت لأبي نواس أخذناها من طبعة ديوان أبي نواس الحسن بن هانئ الحكمي- تحقيق غريغور شولر الصادر عن دار فرانز شتاينر. فيسبان 1982
باسم سليمان
كاتب من سورية
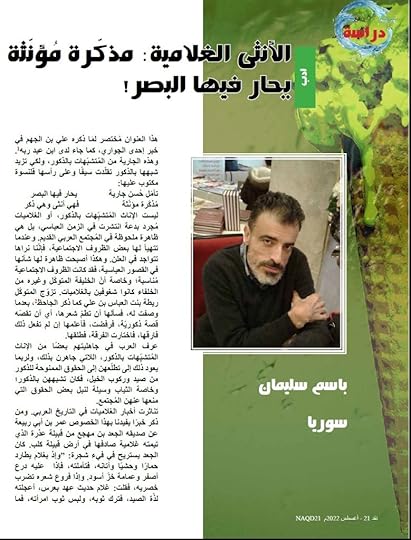
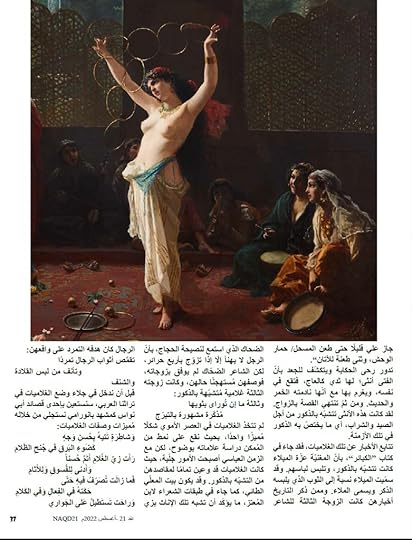
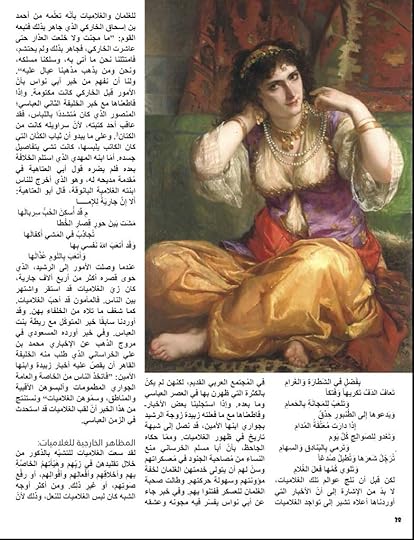

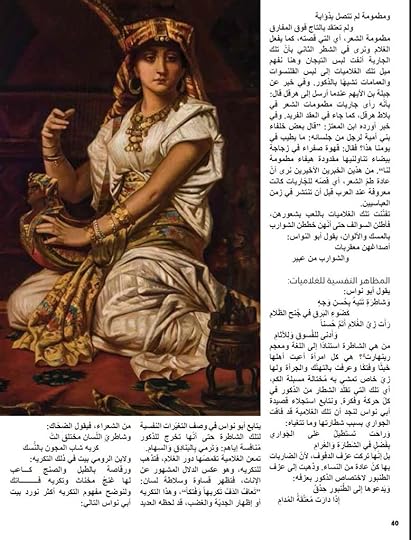
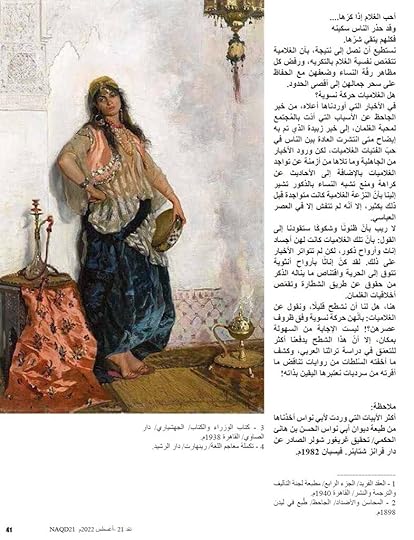
باسم سليمان's Blog
- باسم سليمان's profile
- 24 followers




