باسم سليمان's Blog, page 15
April 1, 2023
شعرة معاوية أطول من شعر النساء – مقالي في رصيف 22 – باسم سليمان

أثار إعلان مجموعة قنوات (إم بي سي) بأنها ستنتج مسلسلاً درامياً تاريخياً عن حياة الخليفة الأموي الأول معاوية بن أبي سفيان الكثير من الجدل. يرتبط معاوية في التاريخ الإسلامي بالكثير من الإشكاليات وخاصة بسبب حربه مع الإمام علي بن أبي طالب، والتي مازالت آثارها متقدة إلى الآن! ومع ذلك، لربما أكثر ما يتذكّر الناس عن معاوية مقولته المشهورة: “ولا أضع سيفي حيث يكفيني سوطي، ولا أضع سوطي حيث يكفيني لساني، ولو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت، قيل: وكيف ذلك؟ قال: كنت إذا مدوها خليتها، وإذا خلوها مددتها”.
يعدّ معاوية من حلماء العرب، ولكي نشرح معنى الحلم عند العرب، نورد هذا الخبر عن الأحنف بن قيس: قال الأحنف بن قيس، بأنّه تعلّم الحِلم من قيس بن عاصم. وهذا العاصم كان سيد أهل الوبر، ويروى عنه قصة، هي التمام بالحِلم، فقد جيء له برجل مكتوف، ورجل مقتول، وكان في داره يحدّث قومه، فقيل له: “هذا ابن أخيك قتل ابنك” فلم يقطع حديثه حتى أنهاه، ومن ثمّ التفت إلى ابن أخيه قائلاً: “يا ابن أخي، أثمت بربك، ورميت نفسك بسهمك، وقتلت ابن عمّك. ثمّ قال لابن آخر له: قم، يا بني، فوارِ أخاك، وحلّ كِتاف ابن عمّك، وسق إلى أمه (أي إلى أم أخيك) مائة ناقة ديّة ابنها، فإنها غريبة”. إنّه لأمر مذهل ما قام به قيس بن عاصم، فهذا هو الحِلم الصافي الذي لا تشوبه شائبة، فقد حفظ القبيلة من التشتت، ووأد الثأر في أرضه، أقلنا الوأد الذي أنكره الإسلام جملة وتفصيلاً! نعم! فقيس بن عاصم كان وائد بنات! فهل اختل مقام الحِلم لديه؟ أبدًا، فالحِلم ليس فضيلة كالكرم أو الخير، يضيرها أقل بخل، حتى لو كان عاذلة تؤنب ضمير الكريم حاتم. إنّ الحِلم الذي أبداه قيس بن عاصم لا يمت بصلة إلى التعريف الذي ساد في الإسلام، بل هو حِلم السياسي، الذي عبر عنه ميكافيلي بأن: الغاية تبرر الوسيلة، كما جاء في كتابه الأمير. لقد كان الأحنف بن قيس من حلماء العرب وله الكثير من القصص التي تروى عن حلمه، وعندما سئل من الأحلم: هو أم معاوية؟ أجاب بأن معاوية هو الأحلم، وكأنه يتمثل قول المتنبي قبل أن يولد: وَلا خَيْرَ في حِلْمٍ إذَا لَمْ يَكُنْ لـَهُ / بَوَادِرُ تَحْـمِي صَفـْوَهُ أَنْ يُـكَدَّرا.
إذن الحِلم يحتاج قوة، والأحنف يعرف بأن معاوية هو خليفة المسلمين، فاستدرك أن يقع في فخ السائل وهو الضعيف أمام جبروت الخليفة، فسلّم الراية إلى معاوية، بأنه الأحلم. وهنا لنبتعد قليلاً عن التجاذبات الإسلامية بين مؤيد لمعاوية ومعارض له، ونذكر ما أورده مارون النقاش في كتابه (أضواء توضيحية على تاريخ المارونية) بأنه عندما اختلفت الكنيسة المارونية مع الكنيسة الأرثوذكسية حول طبيعة المسيح جاؤوا إلى معاوية ليحكم بينهم، فأقرّ رأي الموارنة ومنحهم كنائس كانت تابعة للكنيسة السريانية الأرثوذكسية. وأيضاً عندما حدث الخلاف بين الموارنة واليعاقبة منحهم حق اللجوء إلى جبل لبنان. هذا هو السياسي الذي امتدت إمبراطوريته من الشرق إلى الغرب، والذي أسس أول (فرع مخابرات) في تاريخ الإسلام، وكان يُسمى ديوان البريد، أمّا ناقل الأخبار، فكان يطلق عليه: (صاحب الخبر). لقد حكم معاوية الأمة الإسلامية بشعرة ما انقطعت أبداً.
هند آكلة الأكباد أمّ الخليفة الأموي الأول :
يحكي أبو الفرج الأصفهاني في كتابه الأغاني، بأن هند بنت عتبة أمّ الخليفة معاوية، كانت متزوجة من رجل يدعى الفاكه بن المغيرة. وقد كان رجلاً مضيافاً، له بيت في قريش يزوره الناس من غير إذن. وكان أن خلا البيت يوماً من الضيوف، فاضطجع الفاكه وهند، وبعد فترة نهض الفاكه لحاجة له وتركها نائمة. وحدث أن جاء زائر، فدخل البيت فوجد هنداً نائمة، فخرج هارباً، فرآه الفاكه، فدخل على هند فضربها برجله، وقال من عندك؟ قالت: ما رأيت أحداً، ولا انتبهت حتى أنبهتني. فقال: ارجعي إلى أمك.
كثرت الأقوال بحقّ هند، فذهب أبوها بها مع زوجها الفاكه يحتكمون إلى أحد كهنة اليمن، وفي الطريق تغير سيماء وجه هند، فاستفسر أبوها عن السبب، فأخبرته بأنهم يقصدون رجلاً يخطئ ويصيب، ولا تأمنه أن يسمها بصفة تكون لها مذمّة بين الناس! فقال لها والدها سأختبره لك. فوضع حبة حنطة في إحليل الفرس كي يختبر صدق كهانته. وعندما وصلوا إلى الكاهن، قال له أبو هند، بأنهم قد جاؤوه لأمر، وأنه قد خبأ له أمراً يختبره به، وعليه أن يعرفه، فقال الكاهن: ثمرة في كمرة، فقال أبو هند: بيّن لنا أكثر، فقال الكاهن: حبة بر في إحليل مهر، فقال أبو هند: صدقت، ومن ثم عرض قصتهم عليه، فقال الكاهن لهند: انهضي غير زانية ولتلدي ملكاً يسمى معاوية. وبعد أن ظهرت براءتها، قام الفاكه إليها وأمسك بيدها، فنثرت يدها من يده وقالت: إليك عني، فوالله لأحرص أن يكون ذلك من غيرك. وبعد ذلك تزوجها أبو سفيان، وأولدها معاوية الذي جاء عنه في عيون الأخبار لابن قتيبة، بأن رجلاً قد نظر إلى معاوية وهو غلام صغير فقال: إني أظن هذا الغلام سيسود قومه، فقالت هند: ثكلته إن كان يسود إلا قومه!
لقد نشأ معاوية في حضن هذه الأم القوية، التي لم تتوان عن أكل كبد حمزة في معركة أحد، انتقاماً لقتلى قريش في معركة بدر وهي التي أنشدت في معركة أحد تشد أزر محاربي قريش ضد المسلمين: نحن بنات طارق/نمشي عَلَى النمارق
والمسك فِي المفارق/والدر فِي المجانق
إن تقبلوا نعانق/ونفرش النمارق
أَوْ تدبروا نفارق/فراق غير وامق.
وفي الحديث الذي تناول إسلامها، تتكشف أكثر نفسية هذه الأم التي ربّت معاوية، كما ذكر ابن عساكر في الحديث الذي جرى بين الرسول وبينها عندما أسلمت: “أُبَايِعُكِ عَلَى أَنْ لا تُشْرِكِي بِاللَّهِ شَيْئاً، وَلا تَسْرِقِي ، وَلا تَزْنِي. قَالَتْ: أَوَ تَزْنِي الْحُرَّةُ ؟ قَالَ: “وَلا تَقْتُلْنَ أَوْلادَكُنَّ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ”، قَالَتْ: وَهَلْ تَرَكْتَ لَنَا أَوْلادًا نَقْتُلُهُمْ!” ثم بايعته.
بعد أن تعرفنا على هذه الأم القوية التي ربّت معاوية، هل لنا أن نفسّر تسامح معاوية مع نساء دخلن عليه وهو خليفة المسلمين، وأغلظن له القول، حتى ظنّ السامعون، بأنه سيبطش بهنّ، لكنه على خلاف المتوقّع، استمع لهن ولبى طلباتهن، فهل كان هذا حلم منه، أم رأى فيهن أمّه هند بنت عتبة؟
نساء لا يهبْن معاوية:
ذكرت كتب التراث العربي في ثنايا متونها – كابن بكار وابن طيفور- العديد من القصص التي تناولت أخبار النساء اللواتي دخلن على معاوية وكانت له معهن محاورات لم تهادنه النساء فيها، بل أظهرن عن مواقفهن السياسية والعقائدية غير جزعات ولا خائفات وخاصة في المفاضلة بينه وبين علي، فها هو معاوية يسأل الدارمية الحجونية، إن هو أجاب طلبها، فهل يحلّ محلّ علي في المكانة عندها، فقالت: يا سبحان الله، أو دونه، أو دونه. وما قصدته بأن معاوية لا يمكن له ذلك، فقال معاوية لها:
إذا لم أجد منكم عليكم/فمن ذا الذي بعد يؤمل بالحلم خذيها هنيئاً واذكري فعل ماجد/حباك على حرب العداوة بالسلم.
وهذه الدارمية امرأة، أراد معاوية سؤالها، لماذا أحبت علياً وأبغضته، فتجيبه معدّدة مناقب علي التي لا يملكها معاوية؛ من مثل عدله في الرعية، وما عقد له رسول الله له من الولاية، وحبه للمساكين وإعظامه أهل الدين؛ أما أنت يا معاوية، فقد شققت عصا الطاعة وسفكت الدماء وطلبت ما ليس لك، فقال لها معاوية: صدقت! ولهذا انتفخ بطنك، وكبر ثديك، وعظمت عجيزتك. فردت عليه الدارمية: يا هذا، بهند، والله يضرب المثل، لا أنا. ثم يسألها معاوية إن كانت سمعت كلام علي، فتجيبه: كان والله كلامه يجلو القلوب من العمى، كما يجلو الزيت صداء الطست، قال معاوية: صدقت! هل لك من حاجة؟ فتخبره الدارمية بحاجتها ويجيبها معاوية عليها. وفي ختام المحادثة يقول لها: أما والله، لو كان علياً ما أعطاك شيئاً، قالت: ولا برة واحدة من بيت مال المسلمين- وكانت تقصد إنّ علياً لن يعطيها إلا حقّها- ثم أمر لها معاوية بما طلبت.
وتشبه عكرشة بنت الأطش في جرأتها على معاوية الدارمية، التي دخلت على معاوية بعدما قُطع عنها ما تستحق من بيت مال المسلمين نتيجة موقفها في صفين والذي ناصرت فيه علياً، فقامت تخطب بالجموع المتقاتلة: “إن معاوية دلف عليكم بعجم العرب، غلف القلوب لا يفقهون الإيمان، ولا يدرون الحكمة، دعاهم بالدنيا فأجابوه واستدعاهم إلى الباطل فلبوه…” وبعد أخذ وردّ بينه وبينها عن موقفها في حرب صفين إلى جانب علي، اتهمته أنه من ولّى الفاسدين والخائنين على العراق، فقال لها معاوية مجيباً طلبها: هيهات، يا أهل العراق، فقّهكم ابن أبي طالب، فلن تطاقوا. ثم أمر لها برد صدقتها وإنصافها، وردّها مكرمة إلى العراق.
ولا تختلف أم سنان بنت خيثمة بن خرشة عن سابقتيها، فقد دخلت على معاوية بعد أن حبس حفيدها مروان بن الحكم واليه على المدينة، متظلّمة منه، فاستقبلها معاوية مذكراً إياها بموقفها منه وموالاتها علي، وهي القائلة: هذا علي كالهلال يحفه/ وسط السماء من الكواكب أسعد خير الخلائق وابن عم محمد/ وكفى بذاك لمن شناه تهدد.
فتجيبه أم سنان، بأنها كلمة صدق قيلت، لكنها تطمع فيه أن يكون خلفاً صالحاً لعلي، فيعترض أحد الحضور ويذكرها بما قالته بعد موته: قد كنت بعد محمد خلفاً لنا/ أوصى إليك بنا فكنت وفيا فاليوم لا خلف نأمله بعده/هيهات نمدح بعده أنسيا.
فترد أم سنان، بأنك يا معاوية، ما ورثت كراهة المسلمين لك إلا من المحيطين بك، فإذا ابعدتهم عنك كسبت مودة المسلمين. وفي نهاية القصة يأمر معاوية بإطلاق الفتى من الحبس وإعطاء أم سنان خمسة آلاف درهم، وترد إلى المدينة مكرمة.
هذه بعض القصص عن نساء دخلن على معاوية. وفي كتاب (بلاغات النساء) لابن طيفور العديد غيرها نسجت على ذات المنوال. لاريب أن معاوية كان قد رأى في تلك النساء وجرأتهن ما يشبه جرأة وطموح أمه هند بنت عتبة، لكن إضافة إلى ذلك، كان يعمل بمقتضى سياسة أعلنها بعد أن استتب له الحكم وأزاح منافسيه على السلطة، بأن بينه وبين الناس شعرة على الرغم من رقّتها ودقّتها وضعفها لم تنقطع! وهنا سنسأل: هل سيكون صنّاع المسلسل واعين لتلك الشعرة أم…؟
باسم سليمان
خاص رصيف22
March 29, 2023
في مديح الاختلاف، قراءة المخرج غييرمو دل تورو لقصة بينوكيو
مقالي في مجلة العربية العددالعدد 559 / أبريل / 2023 – باسم سليمان
قد تكون أهم ثيمة لقصة كارلو كولودي، بينوكيو، أنّ أنفه ينمو على أثر أيّة كذبة يقترفها. وتليها ثيمة أخرى، بأنّ أمنية بينوكيو أن يصبح ولدًا طبيعيّا، قد تحقّقت في نهاية قصته. لقد قام كارلو كولودي بتحوير النسخة الأولى التي أبدعها عام 1881-1882 من حياة الدمية الخشبية التي شنقت في نهايتها، جزاء وفاقًا للحياة السيئة التي عاشتها، وجاء ذلك بناء على اقتراح من رئيس تحرير الجريدة التي كان كولودي ينشر فيها قصة بينوكيو متسلسلة، بأن تعدّل نهاية بينوكيوالفجائعية، نتيجة شهرتها الواسعة والمتابعة الكبيرة من قبل القرّاء. هكذا يُعاد بينوكيو إلى الحياة من جديد، فيخوض العديد من المغامرات، حيث تتم مكافأته بعدها من قبل الجنّية، بسبب حسن سلوكه، بأن تجعله فتى بشريًّا، بعد أن كان مجرد دمية من خشب، فيعيش مع أبيه حياة جميلة.
هذه القصة لكولودي ذاع صيتها، فاقتبست أفكارها في الكثير من الأعمال الإبداعية، بل الاجتماعية والسياسية والفلسفية، لكنّ الأكثر شهرة في هذه الاقتباسات، كانت نسخة ديزني السينمائية، التي قدّمت نموذجًا مطهّرًا وتربويّا يحابي خيالات الآباء والأمهات عن أبنائهم. وفي الوقت نفسه يقدّم نموذجًا للطفل يتبعه، حتى تتم مكافأته من قبل الجنّية، ذات الدلالات الأخلاقية والدينية والجمالية.
أمام ضخامة تاريخ قصة بينوكيو، يقف المخرج غييرمو دل تورو مقدّما قراءة أخرى، وبقدر ما يحافظ على الثيمات الأساسية للقصة، لكنّه في الوقت نفسه يجادلها، كاشفًا العنف المضمر فيها، لا على صعيد الشنق الذي تعرّض له بينوكيو، ولا حالة نمو أنفه كغصن كلّما كذب، بل بالعنف والكبت الذي مورس على بينوكيو حتى يفقد جوهره الأصلي كدمية خشبية ويغدو ولدًا طبيعيا، وما إن يتحقّق ذلك، تنتهي القصة. لقد كان حلم بينوكيو أن يصبح ولدًا طبيعيّا، فهل كان هذا ما يريده حقّا، أم هي رغبة المجتمع ممثّلا بوالده والجنية؟ إنّ قراءة غييرمو لبينوكيو تذهب باتجاه الكشف عن أحلام بينوكيو الحقّة، والتي من خلالها سيصبح إنسانًا، بما تعنيه هذه الكلمة من إيجابيات وسلبيات، لكن كدمية خشبية. هذه المحافظة على الأركان الأساسية للقصة من قِبل غييرمو، لم تتأت من رغبته على تأكيد الثيمات الإطارية للقصة، إنّما لينتقد الأنساق الجمالية الأخلاقية المقوننة وما تفرزه من إقصاء اتجاه المختلف، والذي بثّ في القصة الأصلية بشكل واضح. يُعاد بينوكيو بعد الشنق في القصة الأصلية إلى الحياة، ليس نتيجة للسؤال الأخلاقي: كيف تشنقون طفلًا حتى ولو كان دمية خشبية، وإن تسبّب بموت حشرة الصرصار التي تعتبر بمثابة ضميره؟ إنّما لأنّ رغبة الجمهور في التسلية عبر متابعة مغامرات تلك الدمية الحمقاء، كانت هي العامل الحاسم في إعادة بينوكيو من الموت. هذا من ناحية، أمّا من الناحية الثانية، فتنتقد مبدأ الثواب الأخلاقي الموجَّه وفق رؤى معينة، بأن يتحوّل بينوكيو من دمية خشبية على التضاد من حقيقته الأصلية إلى ولد طبيعي نتيجة لسلوكه الحسن، التي سعى المؤلّف كولودي أن يكون متوافقًا بها مع رؤى الفيلسوف جان جاك روسو في التربية وخاصة كتابه إميل، مع أنّ روسو كان يتخلّص من أطفاله الذين أنجبهم من خادمته عبر رميهم في الميتم! انطلاقًا من هذه التساؤلات يشرع غييرمو بإنتاج فيلمه الجديد بينوكيو المصوّر وفق أسلوب إيقاف الحركة، أو ما يعرف بتقنية الإطارات الثابتة، وكأنّه باستخدامه لهذا الأسلوب الذي يعتبر من أقدم أساليب تصوير الرسوم المتحركة كان يؤشِّر، بأنّنا كثيرًا ما ننسى بأنّ إيقاف الحركة، أي أخذ لقطة تصويرية لدمية، ومن ثم تحريك عضو فيها كرمشة عين، وأخذ صورة لها وهكذا دواليك، هو ما يسمح بجعل تلك الأشياء الجامدة تتحرّك وفي الوقت نفسه. إنّ بقاءنا عند أفكار معينة من دون تحركيها وفق مقتضيات تطور الحياة، سيجعلنا جامدين، لا نرى بأنّ التغيّر هو سمة الحياة الحقّة. هذا الأسلوب في التصوير جاء متعاضدًا بشكل ملتحم مع المضمون الجديد والمختلف الذي سيقدّم به غييرمو رؤيته لبينوكيو.
تم تقديم قصة بينوكيو على الشاشات الكبيرة والصغيرة بعدة نسخ، لربما أشهرها المنتجة من قِبل ديزني. وحسب ما صرّح غييرمو دل تورو بأنّ الفرصة قد واتته، بعدما تبنّت نتفليكس 2018 رؤيته الخاصة لبينوكيو بعدما حاول بيعها لهوليوود على مدى خمسة عشر عامًا وقوبل بالرفض، مع أنّه صاحب الأوسكارات والأفلام الخالدة!
تُضاء شاشة غييرمو عن دمية تمثل ولدًا طبيعيّا يُدعى كارلو، تم تصويره وفق ما يشتهي والده النجار جيبيتو لما يكون عليه الولد المثالي. وفي أحد المشاهد ينتقي الولد كوز صنوبر، لكن أباه يقول له: ابحثْ عن الكوز الكامل. وفي مشهد تال نرى النجار يتم صناعة تمثال للسيد المسيح على الصليب مع ابنه كارلو. وعندما ينتهي العمل يعود الولد إلى داخل الكنيسة ليأتي بالكوز الذي نسيه، لكن قذيفة تسقط من إحدى الطائرات على الكنيسة، وتؤدي إلى موت الطفل. يفجع الأب بموت ابنه ويدفنه، ويزرع قرب قبره كوز الصنوبر الذي قذفه الانفجار خارج الكنيسة. تنمو شجرة صنوبر مظلّلة قبر كارلو وتمر الأيام وفي لحظة غضب وجنون وسكر، يقطع النجّار صانع الدمى شجرة الصنوبر، ليصنع منها دمية لابنه. يبدأ النجّار جيبيتو نحت دمية لابنه كارلو تحت تأثير الحزن والغضب واليأس والشوق لابنه، ووحشة الوحدة التي يحياها. فيصنع الدمية تحت تأثير هذه الانفعالات. ولأول مرّة ينحت النجار دمية ناقصة فيها الكثير من فرانكشتاين إيميلي برونتي، بأنف طويل وأذن واحدة ومسامير نافرة وفي مكان القلب فتحة يسكنها صرصار. وأخيرًا يسقط مغمى عليه، وفي الصباح يجد دمية حيّة تقول له: بأنّها ابنه واسمها بينوكيو. يرفض الأب جيبيتو هذه الدمية، فليس فيها من رقّة كارلو ومثاليته أي شبه. لقد صنع دمية حطمت آخر أحلامه، لكنّه أمام إحساسه المرير بفقد ابنه يرضى بتلك الدمية المشوّهة على أمل أن تصبح كارلو آخر، يعوضه عن ابنه الذي فقده. لم يكن بينوكيو دل تورو رافضًا لطبيعته الخشبية، لذلك عندما خاطب المجتمعين في الكنيسة المتعجّبين من دمية تتحرك من دون خيوط، بأنّه سيصبح ولدًا حقيقيًا نما أنفه دلالة على كذبه. وفي مشهد آخر يسأل بينوكيو أباه عن سبب محبة الناس لتمثال المسيح وكرههم له، مع أنّهما مصنوعان من الخشب؟
عبر هذه الخلفية يمضي غييرمو مع بينوكيو إلى زمن الفاشية الإيطالية، بما تمثّله من قمع وكبت وتحويل البشر إلى نسخ تمجّد موسيليني، حيث يقع بينوكيو في حبائل مالك سيرك يقنعه بأنّ الناس تحبّ الدمى المقيّدة بخيوط. وبما أنّ بينوكيو يبحث عن قطيع يشبهه بعد أن رُفض كدمية خشبية، فيجد بالسيرك قناعه الجديد، بعدما نبذ وجهه الحقيقي. يعدّه مالك السيرك ليقدّم عرضًا يمجّد فيه الفاشية، لكن بينوكيو يثور على ذلك ويسخر من موسيليني.
يقطع بينوكيو خيوطه، ولكنّه دمية، تطارده يد عليا، تريد أن تسيطر عليه وتجعله كالقطيع البشري. هكذا يتم تجنيده، فهو الجندي المثالي لأنّه لايموت، بل يظلّ قادرًا على العودة إلى الحياة في كل مرّة، وكأنّه مسيح آخر. رويدًا رويدًا يكتشف جيبيتو، بأنّ الأبوة هي أن تتقبل ابنك كيفما يكون، فيغادر بلدته بحثًا عن ابنه الخشبي. وبعد عدة مغامرات، تبتلع سمكة عجيبة كل من جبيبتو وبينوكيو والصرصار، ولم يكن من حلّ للنجاة منها، إلّا أن يكذب بينوكيو. وهنا يكتشف جيبيتو بأنّ للكذب وجهًا إيجابيّا. يكذب بينوكيو ويطول أنفه، حتى يصبح شجرة يتسلقونها من أجل الهروب من جوف السمكة الضخمة.
كان بينوكيو كلّما مات صعد إلى قاعة فيها جنّية تخبره، بأنّه بعد كل موت عليه أن يقضي وقتًا أطول لديها. وفي هذه المرّة يطلب منها أن تعيده سريعًا إلى الحياة، لأنّ أباه سيموت إن لم يسارع لإنقاذه. تخبره الجنّية التي هي أقرب لسفينكس أوديب، بأنّه إذا خالف مدّة الانتظار لديها، سيكون موته هذه المرّة أبديًا. لا يكترث بينوكيو لذلك، فهو يريد أن ينقذ والده. يصبح بينوكيو فانيًا، ولكنه يظلّ دمية خشبية يعيش مع والده حتى يموت. وبعدها ينطلق بينوكيو ليكتشف العالم من حوله.
ليس ما قُدّم أعلاه، إلّا شذرات دلالية لفيلم غييرمو، فهو في جداله مع النمطية التي عرضت بها القصة عبر سيرها في الزمن البشري منذ لحظة ولادتها على يد كارلو كولودي، أراد أن يفتح القصة على قراءات عديدة ومختلفة، لكنّها متكاملة. فالفيلم يناقش علاقة الوالد بابنه بين الأنا الأعلى والأنا الأصغر وفق فرويد. وهل للأنا الأعلى الحقّ بأن يغيّر من جوهر ابنه من أجل مثالية مقوننة وفق رؤى مجتمع فاشي على سبيل المثال، هذا من جهة. ومن جهة أخرى كان الصرصار في منطلق الحكاية قد استقرّ في شجرة الصنوبر ليكتب سيرته الذاتية، لكن تقوده الأقدار كي يكتب قصة بينوكيو، مع أنّه في القصة الأصلية كان بينوكيو قد قتله. هذا الغفران الذي يمثّله الصرصار، افتقده كلّ من مالك السيرك والضابط الفاشي والمصلين في الكنيسة، عندما أعلنوا بأنّ بينوكيو من عمل الشيطان. في القصة الأصلية كان الصرصار ضمير بينوكيو، لكن في رؤية غييرمو يتعلّم الصرصار من بينوكيو!
في رواية فرانكشتاين لإيميلي برونتي يلتقي الكائن المرعب بأحد العميان، فلا يرتعب منه، بل يقبله كما هو، ويصبح صديقه، ويأخذه ليرى عائلته التي تهلع وترتعب من فرانكشتاين. وهنا يتحوّل فرانكشتاين إلى وحش لا يستكين حتى يقتل صانعه. لا يختلف بينوكيو عن فرانكشتاين، فكلاهما منبوذان، لكن أجزاء فرانكشتاين بشرية، وأجزاء بينوكيو خشبية؛ وفي هذا إشارة للعنف المتجذّر في الطبيعة البشرية التي رفضها بينوكيو، لأنّه في الأساس شجرة حملت من صلَبَه الناس، وكان فداء للبشرية. ما رغب غييرمو بقوله، بأنّ الاختلاف فضيلة، وهو ما يجمعنا ويجعلنا بشرًا. وما يفرّقنا ويبعدنا عن بشريتنا هو التشابه، بل إنّ الحروب والعنف والقتل والإبادة تنشأ من الهاجس المجنون في جعل البشر نسخ متشابهة، أرقامًا في زمن لا ينتهي به العدّ.
بينوكيو من إخراج وسيناريو غييرمو دل تورو، وتمثيل: غريغوري مان، ديفيد برادلي، وكيت بلانشت وآخرين، إنتاج عام 2022.
باسم سليمان
خاص مجلة العربية


March 14, 2023
ذات يومْ
ألقي عكازتي جانبًا وأرقص كزوربا – باسم سليمان – السفير اللبنانية
.
أنا كائنٌ بستة أطرافٍ، هذا ما انتهى إليه تطوري الدارويني: ساقان، يدان، عكّازان؛ والذي يؤكّد هذا التطور، شعوري -أحيانًا- بأنّني سرطانُ بحر يقف على قوائمه الأربعة ويشعل سيجارته بكُلّابتيه، أو كنغرٌ يقفز، يحمل في جرابه كُتبًا أو إنسانًا. وفي النهار أغدو رجلًا «سايبري/ آلي» مزود بأطراف من ألمنيوم وبلاستيك وخشب لينجز مهمة في كوكب غير صالح لحياة البشر، أمّا في الليل، فأسندُ العكازين على حائط قرب السرير وأتوفّى.
كلّ ما سبق يمنحني هبة وحدة الوجود التي تكلّم عنها الحلاج: ليس في هذا الكفن إلّا الدود؛ فكلّما نظرت إلى صور طفولتي أجهد لأتعرّف عليّ، وكأنّ هذه الصّور قد سُرقت من ميتم، وزجّت في ماضي جسدي؛ وكثيرًا ما يراودني يقيني عن شكّي أن أجري فحصًا جينيًا بين الورق المقوى الذي احتضن هذا الطفل السليم والرجل الملدوغ بأفعى جلجامش، لكنّني أرضخ منذ البداية وأعطي ذاك اليتيم من الماضي؛ إطارًا من الحلوى ليضع فيه صورته المكبّرة بالحمض في ظلمة الرحم.
بدأ مرضي في زمن كانت الذاكرة فيه كخرم الإبرة، فلم اعتن بأرشفة تآكل الحركة في مفاصلي؛ ولمّا أصبحت الرجولة تحتاج مرآة أشحتُ بنظري عن كلّ الجداول، فلم أصب بالنرجسية، وأفشلت خطط سيغموند فرويد في تعقب تأقلمي الذي يشبه ذنب السحلية، كلما قطعته نما مرّة أخرى.
لأقل بأنّ مرضي يشبه العيون التي في طرفها حور/ مرض؛ هكذا صرتُ أمدحه إلى درجة أتمنى أن تُقطع ساقي؛ كي أصبح كجون سيلفر في رسوم المانغا وأتباهى بمهارتي باستخدام عكازي كأعواد الأكل اليابانية؛ ألتقط بها مفاتيحي عن الأرض، أو أغازل بها من تحت الطاولة ساق فتاتي عندما تقصر رجلي عن ذلك؛ أو أمدّ عكازتي مُلمّحًا إلي شبهٍ بذيءٍ لها؛ ومرّة عندما هالني صدّ بيضة خدرٍ قلت لها: إنّ كان المسيح قد مشى على الماء، فأنا قادر على المشي على الهواء، عندها رفعتُ ساقي واستندتُ على عكازي، وبدأتُ المشي كغراب إلى بحيرةِ قلبِها المزروع بأنصال العشب.
يا للتخييل الأدبي السابق كم يشبه وعود الأنبياء الميتافيزيقية! أحقًا، للمرض هذا الجانب الجمالي! لكن أليس الموت هو مرض الحياة وهو مبتدأ الفن؟ ألم يحاول الإنسان أن يخبئ تفسخّه وتحلّله عبر رجْم من الحجارة، فذهب إلى تهذيبه بالنحت وبالرسم وإحياء ذكرى الوجود لكائن قد انتهى، عبر الموسيقى والغناء والشعر؟ أيحول الفن، الممكن إلى واجب الوجود؟
يغويني الاشتقاق اللغوي الجناسي لفظًا وصوتًا، فالأفنون؛ هو الغصن اللين الطري الغرّ؛ كما آدم في الجنّة؛ كما جلجامش في حبّه لأنكيدو الذي هو نقيضه. والأفنون هو الأفعى بالتفسير الكلاسيكي التي أغوت آدم وسرقت عشبة الخلود من جلجامش؛ وهنا أليس جذر الأفنون في « فَنَنَ» والفنّ أليس من ذات الأرومة؟ أية لعبة تلعبها الأفعى؟ الأفعى التي تلقفتها عصا/ عكاز موسى، موسى الذي يهشُّ بها على غنمه وله مآربٌ أُخرى؛ كما أهش بعكازي على ذباب الحياة؛ كأنّها ذنَبٌ نبت تحت أبطي بدلًا من الذنَب آخر فقرة في عامودي الفقري؛ والتي تُسمى العصعص؛ والعصعص جذره في « عصص» و «عصّ» تعني العصا والشجرة؛ وماذا عن الجناس بين « ذَنب» وذَنْب»؟
ألقي عكازتي جانبًا، وأرقص كزوربا؛ يذهب التراث البشري إلى عدّة تفسيرات وتأويلات للمرض، بلاء ؛ لِيُرى من هو الأحسن عملًا وصبرًا؛ أو «الكارما» حيث الجيل الحالي نتاج الحياة السّابقة؛ أو أنّ المرض من طبائع الحياة ومصادفاتها العبثية، لكن أليس في رفض خلية السرطان الموت وتكاثرها رغبة في الخلود؟ فما الطفرات التي قادت نظرية التطور الداروينية إلا أمراض أصابت الكائنات الحيّة؛ ومن صبر على مرضه نجا؛ وشكّلَ جنسًا جديدًا.
هكذا كان النبي أيوب صابرًا على مرضه حيث أكل لحمه الدود في أرض تُسمى أرض «عوص» وعوص تعني الشجرة / العصا/ العكاز حتى منَّ الله عليه بالشفاء وتكاثر كرمل الشواطئ.
المرض توأم سيامي، يُفصل بالشفاء وماذا عن توأمي أو توائمي، فالعكازان توأم ثالث لنا، أخبئ أخوتي وأدّعي أنّي وحيدٌ هكذا تقول السجلات المدنية، فأتهرب من الخدمة العسكرية؛ ومن إنجاب قاتل وقتيل مقلّدًا المعري قائلًا: «هذا ما جناه أبي عليّ وما جنيت على أحد» لكن هيهات..هيهات.. فمن الصعب أن ألعب بالبيضة والحجر أمام سحر الاشتقاق اللغوي حيث المثل يقول ويضرب مثلًا: “العصا لمن عصى”.
ألم يغو الشيطان آدم بأن يذق الشجرة التي ستعطيه الخُلد ومُلكًا لا يبلى؟ وما الملك والخلد لكائن قُدِّر عليه الموت إلا قهر الموت بالتناسل، فالعكازان ليسا أخيْن لي؛ بل ولديي اللذين حملاني كما فعل إينياس بأبيه أنشيز عندما سقطت طروادة وهرب به، أفكر بابنيّ وماذا أورثهما غير أبطين لم يتأبطا دودًا.
الكائنات ذوو العكاكيز تتكاثر الآن في بلدي؛ أشعر بأنّني الآن بين شعبي حيث الحرب تنجز مهمتها الديمقراطية؛ وتلغي احتكار الأصحاء للأكثرية العددية، فنحن الأقلية المريضة التي لم تعطِ من سوق العمل؛ إلّا أربعة بالمائة من عدد الموظفين؛ فيما الأصحاء يتمتعون بالبطالة المقنّعة؛ وسيسمع صوتنا بأن المرضى يريدون إسقاط لعبة الأسماء بين المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة؛ وبدلًا من البنادق والأعلام ستُرفع العكاكيز في السماء؛ معلنة انتهاء حرب الأصحاء على السلطة.
العكاكيز
احتفظ بعكازاتي جميعها، تلك القطع الخشبية اليابسة منحتني حرية الغصون عندما تهبّ الريح. إنّها تشبه الآثار التي يجتاحها دود التاريخ الآن -آه- كم تعكّزنا، نحن، أولاد الآني على آثار تدمر وقلعة حلب..
كلّما فكرت كم من أرجلٍ بترتها الحرب؛ أتذكر أن أقدم ناي في التاريخ صُنع من عظمة الظنبوب في الساق. إلى الآن لا أعرف لماذا لا تصنع صواري الأعلام من العكاكيز، فالعائدون من الحرب هم الأولى أن تُسقى أخشابهم لكي تنبت الغابات من جديد، لكن من سينتبه لرجل بساق مقطوعة أو مشلولة؟ مادام المرض عورة يجب سترها؟ ألا يكفينا أن نعلم أن أجمل بيت غزل في الشعر العربي قد تمّ تحويره هو في الأصل : «إنّ العيون التي في طرفها مرض.. وليس حوراً».
كان أبي أستاذاً للفلسفة وفي ذلك الزّمان كانت العصا من مكملات المعلّم وفي كلّ صفٍ كان هناك عصا؛ فعندما يتكاسل الطالب تطاله العصا، فهي بيد السلطة تنمو إلا أن أبي كان يضرب الطاولة فيها؛ ثم يخرج إلى خارج الصف؛ وفي ساحة المدرسة على الحدّ الشرقي، غرسها في التراب، ومضى.
مضى الزمن ونمت عصي الرّمان شجيرات يلتهبن بزهر الجلنار؛ وفي الصيف يمر طائر الشقراق السوري ويتناول رمانة، يفرّغها من حبها ويملأها عنبًا ويمهلها زمنًا ولمّا يحين الوقت يعود لها وقد تحوّل العنب خمرًا، فيشرب كأبي نواس.
يشتد الألم قليلًا أتناول حبّة أسبرين من شجرة الصفصاف وأحلم؛ كم من الرّمان والصفصاف والقصب والعكاكيز تحتاج هذه البلد لتشفى من أمراضها؛ فيما يتسلل النعاس إلى محجر نومي، تومض فكرة قديمة من عمر الكلمة: السّلام هبة العنف والصحة هبة المرض.
نص قديم نشر في السفير اللبنانية
نص قديم نشر في السفير اللبنانية


صحِّ النوم – باسم سليمان – رصيف22
لنا أن نعتبر النوم آلة سفر عبر الزمن والمكان والذات الإنسانية، وهذا ما أشار إليه مارسيل بروست في كتابه الزمن المفقود، فهو بعد أن يستيقظ، يكاد ألا يتعرّف على نفسه، وكأنه أصبح في مكان وزمن آخرين وشخصية أخرى. وفي حكايا التراث الديني ما يشبه ذلك، فهناك قصة النائمون السبعة، أو أهل الكهف الذين أنامهم الله، أكثر من ثلاثمئة سنة، في كهف لا تدخله الشمس، إلى أن انقضى حكم من كان يضطهد إيمانهم بالله، وكأنه سافر بهم عبر النوم إلى المستقبل.
تقدّم لنا الأسطورة الإغريقية بأن هبينوس/ إله النوم، وثاناتوس/ إله الموت، على أنهما ابنا آلهة الليل. كان الشاعر أوفيد يسمي النوم “الموت المزيف” الذي يعيش في كهف لا تنفذ إليه أشعة الشمس أبداً. وعند بوابة هذا الكهف تزهر نباتات الخشخاش وعدد آخر كبير من النباتات المخدرة التي يستقطر منها هبينوس تلك السوائل التي تسبب النوم. ولا تختلف عنه التقاليد الجرمانية القديمة التي ترى، بأن النوم والموت أخوان. وكانت تصف إله النوم، بأنه رجل الرمل، لأن من يصيبه النعاس بشدة، ولا يعود قادرًا على فتح أجفانه، يقول بأن هناك رملاً في عيونه.
هذا التشابه بين النوم والموت، كأنهما شقيقان، نجده في قصة لعازر الذي بعثه المسيح من الموت. قال المسيح لتلاميذه: ” لقد آوى لعازر إلى النوم، ولكني أعمد إليه لأوقظه من النوم”.
ترى الفلسفات الهندية بأن هناك أربع حالات من الوجود: حالة اليقظة- الحالة الحالمة- حالة النوم العميق – حالة الوعي الفائق. أما حالة النوم العميق، فإنها الحالة التي لا يرغب المرء فيها شيئاً، ولا يحلم بشيء. وفي هذه الحالة من النوم العميق يتصل النائم بالذات الحقّة له، التي لا تعرف الخوف وتكون على اتصال ببراهما إله الكون. وهذه الرؤية الهندية تتشابه مع ما كتبته راهبة ألمانية تدعى هيلد جاردمن بنجمن في القرون الوسطى ترى ارتباط النوم بالطعام وسقوط آدم من الجنة. وهي ترى بأن حياة الإنسان تقسم إلى: اليقظة والنوم. ويأخذ الإنسان غذاءه من الطعام والراحة، وأن آدم قبل الخطيئة كان يتغذّى وهو نائم من خلال عينيه المغلقتين، فنومه كان نوماً عميقاً- وهنا لنا أن نشابهه بالنوم العميق عند الفلاسفة الهنود- لكن بعد أن أخطأ آدم أصبح ضعيفاً لذلك فهو يحتاج للطعام. وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فالتوراة قصّت بأن حواء خلقت من ضلع آدم بعد أن ألقى الله عليه سباتاً عميقاً!
ربط الفلاسفة الإغريق النوم بالعناصر الأربعة: النار، التراب، الهواء، والماء وخاصة أمبادوقليس الذي كان يرى النوم بأنه انسحاب عنصر الحرارة من الجسم. ولا يختلف أبقراط عنه إذ يقول، بأن النوم هو انسحاب الدم إلى الأعضاء الداخلية وهذا ما يسبب برودة أطراف النائم. أما أرسطو فقد ربط النوم بالطعام، الذي تصعد أبخرته إلى الرأس فتتجمع وتسبب النوم.
إن النوم طبيعة بشرية، لا تتعلق بالآلهة، فالتوراة تقول: “أبصر، إن الذي يحفظ إسرائيل، لايغفل ولا ينام” وفي القرآن: “لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ” لكن في قديم الزمان كانت الآلهة تحب النوم فكما تذكر الأسطورة البابلية الإينومليش بأن إله المياه المالحة/ أبسو وزوجته تعامة أزعجتهم الآلهة الجديدة لكثرة نشاطها ويقظتها، فقررا قتلها إلا أن مردوخ الذي عيناه لا تنام انتصر عليها وخلق الكون.
فــــما أطـــال الـنوم عـــــمراً ولا قصر فى الأعمار طول السهر:
هذا البيت الشعري لعمر الخيام، وقد غنته أم كلثوم وعلى ما يبدو لم يكن النوم ممدوحاً من قبل الفلاسفة والشعراء، فنيتشه كان يكره النوم ويراه تضييعاً للطاقات. ومع ذلك كان يحسد هؤلاء الذين ينامون، يقول نيتشه في كتابه هكذا تكلم زرادشت: “طوبى للنِعاس، سينامون قريباً” أما أفلاطون فكان يستهجن النّوّم مثل معلمه سقراط الذي شبه نفسه بالذبابة التي تلسع النائمين ليستيقظوا وكان يقصد بالنائمين أهل أثينا، لذلك كانوا يريدون قتله، لكنه تمنى أن يرسل الإله لهم ذبابة أخرى توقظهم من سباتهم. تقدم الكتب المقدسة أحكامًا عن النوم، فالتوراة تمسك العصا من منتصفها، فتارة تحث على النوم والتمتع به: “إِذَا اضْطَجَعْتَ فَلاَ تَخَافُ، بَلْ تَضْطَجعُ وَيَلُذُّ نَوْمُكَ” وتارة أخرى تزدريه: “إِلَى مَتَى تَنَامُ أَيُّهَا الْكَسْلاَنُ؟ مَتَى تَنْهَضُ مِنْ نَوْمِكَ”. لا تبتعد المسيحية عن أحكام النوم في التوراة مع أن الدعوة إلى قيام الليل بالصلاة والصمت منتشرة في الجانب الصوفي من المسيحية. أمّا الإسلام، فله أحكام عديدة، كتحبيذ النوم على الجهة اليمنى استناداً إلى حديث الرسول: “إذا أتى أحدكم فراشه؛ فليتوضأ، ثم ليضطجع على جنبه الأيمن” وكراهة ابتداء النوم على الجهة اليسرى، لكن في العموم يقال: “كلٌ ينام على الجنب الذي يريحه”، فلا أحد يتمنى أن يحرم من النوم. تعدّ عقوبة المنع النوم من أشد العقوبات التي تمارس بحق السجناء، فالسجين قد يحتمل التعذيب مطولاً، لكنه ينهار بعد أيام من انعدام النوم، مما يسمح للسجّان أن يستخلص منه ما يريد من اعترافات. على الرغم من أن ديكارت كان يحب النوم حتى ساعة الظهيرة، إلا أن مقولته المشهورة في فلسفته تناقض رغبته:” أنا أفكر، إذن أنا موجود” في النوم تنقطع سلسلة التفكير، لكن سيغموند فرويد يرى بأن الأحلام رسائل اللاشعور المكبوت، وهي نوع من التفكير تحت اللاشعوري، فعلى ما يبدو لا يناقض النوم مقولة ديكارت.
النوم سلطان، وهو السلطان الوحيد، إلى جانب سلطان الحب، نتمنّى أن نقع تحت حكم أحدهما، عندما يستبد بنا التعب والأرق والتوق إلى النصف الآخر. لكن السلطانين يتنازعان المحبّ الأرق. فالأول يريد أن يدخله في عباءته، وله ما شاء من الأحلام وطيف الحبيب الزائر، أما سلطان الحب، فهاجسه أن يبقى المحبّ راعي نجوم، يقول بشار بن برد: لم يطل ليلي ولكن لم أنم ونفى عني الكرى طيفٌ ألمّ وإذا قلت لها جودي لنا خرجتْ بالصمت عن لا ونعم.
أو كما تقول فيروز:
من عزّ النوم بتسرقني
بهرب لبعيد بتسبقني. لا يتصالح السلطانان إلا عندما يتوسّد المحبّ ساعد الحبيب، أو حضنه، أو سريره، فيغفو، ليترك كلّاً من النوم والحب يتنادمان على صوت أنفاسه الهادئة.
يقول محمود درويش على لسان الحبيبة: “لا أَنامُ لأحلم قالت لَهُ/ بل أَنام لأنساكَ. ما أطيب النوم وحدي/بلا صَخَبٍ في الحرير”. إن الرغبة في النوم، رغبة في النسيان وخروج من الزمن، كما حدث للأميرة النائمة، ولولا قبلة الأمير، لظلت المملكة نائمة إلى الأبد. هذه القبلة هي من توقظ الغرقى من نوم الموت.
بعيدًا عن أحكام القيمة التي تخصُّ النوم إيجابًا أوسلبًا، هناك جانب آخر للنوم يخصّ شكل النوم الذي نشتهيه، فمع أن الفيلسوفة فيليبا فوت من أكسفورد تقول من غير الأخلاقي تصوير النائم وضمنًا مراقبته، إلا أن رواية ياسوناري كواباتا، الجميلات النائمات، قامت على خرق هذا المحظور.
نوم الأطفال:
هو الحلم المشتهى لكل أرق، أن ينام كما ينام الأطفال. هو نوم يحدث كما التنفس، فالطفل ينام عندما يشاء إله النوم ورائحة الأم، فننشد له: نم في سريرك يا ملك أنت الفتى ما أجملك.
هذا النوع من النوم نغادره، كلما تقدمنا في الزمن، ليصبح ذكرى عن كيف كان النوم حرية تامة بالانسحاب من نهر هيراقليتس ومن ساعة المنبه. وكأن لسان حالنا لسان المتنبي: أَنامُ مِلءَ جُفوني عَن شَوارِدِها.
لا أحد ينام ملء جفونه غير الأطفال، لذلك نحاول أن نجعل من لباس النوم والسرير يحتويان على الكثير من القطن، لا الحرير ولا الدانتيل، فهذه الأقمشة لنوع آخر من النوم، النوم بين أحضان الحبيب.
أريد النوم معك:
هناك أسماء وصفات ونعوت كثيرة لممارسة الجنس، ليس أولها النيك ولا النكاح بل النوم. كثيرًا ما يتم التعبير عن الرغبة بممارسة الجنس/ الحب مع الحبيب بالعبارة التالية: أريد أن أنام معك. هذه العبارة وإن يدل منتهاها على مشاركة السرير مع الحبيب، لكن مبتدأها يدل على الرغبة بالمتعة الجنسية المطمئنة التي تقود إلى نوم هانئ على إثرها، بل وأكثر من هذا، فهذه العبارة تشي بطمأنينة الإعلان عن الرغبة تجاه الشريك من دون تبعات، كمن يعلن عن نعاسه فلا أحد يزدريه، فهو لا يرتكب خطأ تحت أي مسمى. وهكذا تغدو عبارة: أريد النوم معك- مفتوحة الكاف أو مكسورة- أبلغ العبارات الجنسية التي لا يتبعها قلق، أو أرق، أو تأنيب ضمير.
هذا من جانب الحبيبين. أمّا من العذول، فكثيرًا ما تحمل تلك العبارة الاتهام، لكن مع الحسد، لأنها تشي بتلك الرغبة المقموعة أن يتحصّل العذول على النوم الجنسي إن صح التعبير.
نوم الأجنة:
يقال رفع القلم عن النائم، فالنائم يأتي بحركات ويتلفظ بكلمات غير مسؤول عنها، حتى أن هناك من يمشي في نومه. ولربما أشهر الوضعيات في النوم هي تلك التي تشبه وضعية الجنين في رحم أمه. حيث يتكوّر النائم على نفسه وكأنه يسترجع ذكريات غامضة عن تلك الجنة المائية عندما كان يعوم في بطن أمه. ولكن كثيراً ما يفسر هذا الشكل من النوم كتعبير عن الانطواء تجاه الوجود، وكما قال فرويد عن الأحلام، بأنها رسائل مكبوتة، كذلك شكل النوم. فهناك من ينام كالرجل الفيتروني الذي رسمه دافنشي تعبيراً عن انطلاقه في الحياة. وهناك من ينام على جانبه الأيمن أو الأيسر، أو يظل يتقلّب طوال الليل كعاصفة لا تهدأ حتى الصباح. وهناك من ينام كخشبة لا يتزحزح من وضعية نومه حتى الاستيقاظ. وهناك من يفضل النوم عاريًا ليسمح لجسده أن يتنفس بعيدًا عن كل لباس.
النوم مع العدو:
يعني النوم مع الآخر، بدءاً بالأهل، وانتهاء بالزوج والأبناء، تسليماً بأن من ننام معه هو الأمان كله، فالنائم كالميت لا يدري ما يُفعل به، لذلك كانت محظورات النوم مع الآخر عبر تاريخ الإنسان كثيرة. لكن الحياة تقودنا إلى النوم مع آخرين لا تربطنا بهم علاقات واضحة كالجنود الذين يفترشون الخنادق في هدأة الحرب. والمساجين الذين يتقاسمون مساحة السجن الضيقة. كل منهم ينام، وهناك خوف مبهم، ليس من القذائف ولا الجلاد، بل من الآخر الذي يشاركه مكان النوم.
النوم في أسرة البيت، أو أرضية السجون والخنادق، قد تكشف عن عدو لم يكن متوقعًا، فالعديد من جرائم الاعتداءات الجنسية يكون مسرح وقوعها أسرّة البيوت. كذلك قد يذهب سجين ضحية لسجين آخر حين يغدره وهو نائم، أو مجموعة من الجنود قد أمّنوا على حياتهم لدى جندي يحرسهم في غفلة النوم، إلا أنه قد خان الأمانة، كأن يتركهم نهبًا للعدو، أو يقوم هو بإزهاق حياتهم عبر رصاصاته التي كان يجب أن تُوجّه إلى الجهة المقابلة في الجبهة. ولا ريب أن شمشوم أشهر من تمت خيانته وهو نائم على يد دليلة، حيث جزّت شعره وهو مصدر قوته وفقأت عينيه.
ثياب النوم:
يعتبر القطن سيد ألبسة النوم، فنعومته ومشاكلته للجسد تسمح له بأن يحتضن النائم بكل عطف ودفء. أمّا الحرير، فله مآرب أخرى قبل النوم، حيث الغواية بأبهى صورها عندما ترتديه النساء لأجل ليلة حمراء. يسانده في ذلك الدانتيلا التي تشبه الشبابيك، فتسمح برؤية موشاة بالغموض لأشد المواضع حميمية، فيشتعل الخيال على أرض السرير. لكن هناك من يرفض هذه الأقمشة ويرتدي مسوح التقشف من الكتان والصوف حتى يكون نومهم تعبداً لله حتى وهم لا يشعرون.
ونختم هذا المقال بما كتب الروائي الروسي إيفان غونتشاروف رواية عن أوبلوموف الذي كان يحب النوم لدرجة أنه لا يغادر فراشه: “لم يكن الرقاد ضرورة بالنسبة لأوبلوموف، كما هو الحال بالنسبة لمن كان مريضاً أو يغلبه النعاس. ولم يكن أمراً يفرضه التعب أو رغبة الخامل في الاستمتاع، وإنما كان الرقاد بالنسبة له هو الحالة السوية” ألا يذكّر أوبلوموف بالإلهين أبسو وتعامة؟
باسم سليمان
https://raseef22.net/article/1092023-%D8%B5%D8%AD-%D8%A7%D9%D9%D9%D9خاص رصيف22
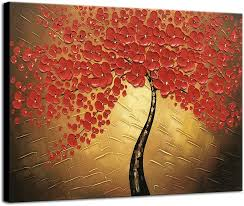
March 6, 2023
بينوكيو دل تورو، للكذب وجه إيجابيّ مقالي عن فيلم بينوكيو في الصباح العراقية- باسم سليمان
قد تكون أهم ثيمات قصة كارلو كولودي، بينوكيو، أنّ أنفه ينمو على أثر أيّة كذبة يقترفها. قام كارلو كولودي بتحوير النسخة الأولى التي أبدعها عام 1881-1882 من حياة الدمية الخشبية التي شنقت في نهايتها، جزاء وفاقًا للحياة السيئة التي عاشتها. جاء هذا التغيير ذلك بناء على اقتراح من رئيس تحرير الجريدة التي كان كولودي ينشر فيها قصة بينوكيو مسلسلة، بأن تعدّل نهاية بينوكيوالفجائعية، نتيجة شهرتها الواسعة والمتابعة الكبيرة من قبل القرّاء، هكذا يصبح بينوكيو في نهاية القصة ولدًا طبيعيًّا. تم اقتباس قصة بينوكيو كثيرًا، ومع ذلك أراد المخرج غييرمو دل تورو أن يقدم قراءة أخرى، مع محافظنه على الثيمات الأساسية للقصة، لكنّه في الوقت نفسه جادلها، كاشفًا العنف المضمر فيها؛ وذلك لينتقد الأنساق الجمالية الأخلاقية المقوننة وما تفرزه من إقصاء اتجاه المختلف، والذي بثّ في قصة بينوكيو بشكل واضح. انطلاقًا من هذه التساؤلات يشرع غييرمو بإنتاج فيلمه الجديد بينوكيو المصوّر وفق أسلوب إيقاف الحركة، وكأنّه باستخدامه لهذا الأسلوب الذي يعتبر من أقدم أساليب تصوير الرسوم المتحركة كان يؤشِّر، بأنّ بقاءنا عند أفكار معينة من دون تحركيها وفق مقتضيات تطور الحياة، سيجعلنا جامدين، لا نرى بأنّ التغيّر هو سمة الحياة الحقّة.
تُضاء شاشة غييرمو عن دمية تمثل ولدًا طبيعيّا يُدعى كارلو، تم تصويره وفق ما يشتهي والده النجار جيبيتو لما يكون عليه الولد المثالي. وفي أحد المشاهد ينتقي الولد كوز صنوبر، لكن أباه يقول له: ابحثْ عن الكوز الكامل. وفي مشهد تال نرى النجار يتم صناعة تمثال للسيد المسيح على الصليب مع ابنه كارلو. وعندما ينتهي العمل يعود الولد إلى داخل الكنيسة ليأتي بالكوز الذي نسيه، لكن قذيفة تسقط من إحدى الطائرات على الكنيسة، وتؤدي إلى موت الطفل. يفجع الأب بموت ابنه ويدفنه، ويزرع قرب قبره كوز الصنوبر. تنمو شجرة صنوبر مظلّلة قبر كارلو وتمر الأيام وفي لحظة غضب وجنون وسكر، يقطع النجّار صانع الدمى شجرة الصنوبر، ليصنع منها دمية لابنه. ولأول مرّة ينحت النجار دمية ناقصة فيها الكثير من فرانكشتاين إيميلي برونتي، بأنف طويل وأذن واحدة ومسامير نافرة وفي مكان القلب فتحة يسكنها صرصار. لم يكن بينوكيو دل تورو رافضًا لطبيعته الخشبية، لذلك عندما خاطب المجتمعين في الكنيسة المتعجّبين من دمية تتحرك من دون خيوط، بأنّه سيصبح ولدًا حقيقيًا نما أنفه دلالة على كذبه.
عبر هذه الخلفية يمضي غييرمو مع بينوكيو إلى زمن الفاشية الإيطالية، بما تمثّله من قمع وكبت، حيث يقع بينوكيو في حبائل مالك سيرك يقنعه بأنّ الناس تحبّ الدمى المقيّدة بخيوط. وبما أنّ بينوكيو يبحث عن قطيع يشبهه بعد أن رُفض كدمية خشبية، فيجد بالسيرك قناعه الجديد، بعدما نبذ وجهه الحقيقي. يعدّه مالك السيرك ليقدّم عرضًا يمجّد فيه الفاشية، لكن بينوكيو يثور على ذلك ويسخر من موسيليني.
يقطع بينوكيو خيوطه، ولكنّه دمية، تطارده يد عليا، تريد أن تسيطر عليه وتجعله كالقطيع البشري. هكذا يتم تجنيده، فهو الجندي المثالي لأنّه لايموت، بل يظلّ قادرًا على العودة إلى الحياة في كل مرّة. رويدًا رويدًا يكتشف جيبيتو، بأنّ الأبوة هي أن تتقبل ابنك كيفما يكون، فيغادر بلدته بحثًا عن ابنه الخشبي. وبعد عدة مغامرات، تبتلع سمكة عجيبة كل من جبيبتو وبينوكيو والصرصار، ولم يكن من حلّ للنجاة منها، إلّا أن يكذب بينوكيو. وهنا يكتشف جيبيتو بأنّ للكذب وجهًا إيجابيّا.
كان بينوكيو كلّما مات صعد إلى قاعة فيها جنّية تخبره، بأنّه بعد كل موت عليه أن يقضي وقتًا أطول لديها. وفي هذه المرّة يطلب منها أن تعيده سريعًا إلى الحياة، لأنّ أباه سيموت إن لم يسارع لإنقاذه. تخبره الجنّية التي هي أقرب لسفينكس أوديب، بأنّه إذا خالف مدّة الانتظار لديها، سيكون موته هذه المرّة أبديًا. لا يكترث بينوكيو لذلك، فهو يريد أن ينقذ والده. يصبح بينوكيو فانيًا، ولكنه يظلّ دمية خشبية يعيش مع والده حتى يموت. وبعدها ينطلق بينوكيو ليكتشف العالم من حوله.
في رواية فرانكشتاين لإيميلي برونتي يلتقي الكائن المرعب بأحد العميان، فلا يرتعب منه، بل يقبله كما هو، ويصبح صديقه، ويأخذه ليرى عائلته التي تهلع وترتعب من فرانكشتاين. وهنا يتحوّل فرانكشتاين إلى وحش لا يستكين حتى يقتل صانعه. لا يختلف بينوكيو عن فرانكشتاين، فكلاهما، مختلفان ومنبوذان، لكن أجزاء فرانكشتاين بشرية، وأجزاء بينوكيو خشبية؛ وفي هذا إشارة للعنف المتجذّر في الطبيعة البشرية التي رفضها بينوكيو. ما رغب غييرمو بقوله، بأنّ الاختلاف فضيلة، وهو ما يجمعنا ويجعلنا بشرًا. وما يفرّقنا ويبعدنا عن بشريتنا هو التشابه.
بينوكيو من إخراج وسيناريو غييرمو دل تورو، وتمثيل: غريغوري مان، ديفيد برادلي، وكيت بلانشت وآخرين، إنتاج عام 2022.
باسم سليمان
خاص الصباح
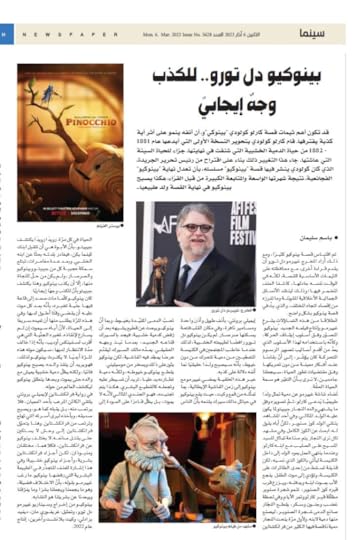
March 5, 2023
الصمت حمّال أوجه- مقالي في ضفة ثالثة – باسم سليمان
إنّ أبسط مفهوم للصمت يكمن في موضعته مقابل الكلام، لكن الخطاب اللغوي بذاته مداورة بين صائت وصامت! وإذا كان الصمت بدوره يصوّر كإسكات للكلام، إلا أنه ليس مسحًا للمعنى، فالنُّصْبَة (1) التي عدّها الجاحظ دلالة على المعنى ليست بكلام، هي إحدى هيئات الصمت. ولو تكلّمنا عن الصمت، هل نمحوه؟ أم أن هذه التضادية بين الكلام والصمت، هي ما يسمح للقول البشري بالوجود.
يمتلئ التراث العالمي والعربي بحكايا وعبر في مديح الصمت، وإذا كان لنا أن نختار واحدة كبداية لهذا المقال، فستكون هذه: “سأل رجل أحد الحكماء: متى أتكلم؟ فقال له الحكيم: إذا اشتهيت الصمت. وعاد الرجل يسأله: متى أصمت؟ فقال الحكيم: إذا اشتهيت الكلام”. تمتاز هذه الحكاية بأنها تضع الصمت عديلًا للكلام، فإذا كان الكلام مهماز الصمت، فإن الصمت لجام الكلام، وكأننا مع تنظيم أرسطو لأقسام الخطاب: إيجاد مصادر الحجة، تنظيم أجزاء القول، الأسلوب، الإلقاء. إن المدقّق بمنهج أرسطو يجد أن ثلاثة أجزاء الخطاب المعبِّر عن الفكر والثقافة يغلّفها الصمت، وأمّا الجزء الرابع، فيمثله الصوت/ الكلام. وعليه نستنتج من منهج أرسطو بأن اللغة والفكر والثقافة ولدوا من هذه العلاقة الجدلية بين الكلام والصمت؛ فالفكر لولا مساحة التأمل السابقة على قوله، لكان خبالًا. واللغة المعبَّر عنها بالكلام لولا الصمت لأصبحت دون متلق، أمّا الثقافة فقد أظهرت هذه العلاقة بتعريفها البلاغة بأنها: “ما قلّ ودلّ” أي ما أصاب مقتلًا بعد القول. والمقتل، هو الصمت الناتج عن قوة الحجّة والبيان.
ترجع بنا أسطورة الخلق البابلية إلى أول جدال بين الكلام والصمت، فعندما ظهرت الآلهة الشابة، وبدأ كلامها يقلق سكون الآلهة القديمة: أبسو وتعامة، قرّرا القضاء عليها، وإعادة الأمور إلى نصابها الأول، حيث السكون الأبدي، لكن الإله الجديد مردوخ، الذي وصف بأن كلمته هي العليا وقوله لا يخيب (2)، انتصر على آلهة السكون وخلق السماء والأرض.
إن علو الحركة على السكون، والكلمة على الصمت في الأساطير القديمة تؤكّده الديانات التوحيدية، حيث تمنح الكلمة قوة الخلق والدليل الحاسم في المحاجة بين الأنبياء والكفار. فالنبي إبراهيم بعد أن كسر الأصنام خاطب قومه، بأن يسألوا آلهتهم إن كانوا ينطقون! إن عدم قدرة الأصنام على النبس ببنت شفة، وصمتهم المطبق دليل على أنهم ليسوا آلهة. وهذا ما فعله النبي إيليا في جداله مع الكهنة الذين اتبعوا البعل، فبعد يوم طويل من الابتهال له من قبل الكهنة لم ينطق صنمهم، في حين ما إن نادى إيليا إلهه حتى أجاب.
إن تفضيل الصوت/ الكلمة على الصمت في الأساطير والديانات التوحيدية يعود لأن كلمة الإله مطلوب سماعها، لذلك نجد الحضّ على إصمات كلمة الإنسان، كي يتحقّق الإنصات للكلمة الإلهية. وهذا يُرى بشكل واضح في المذاهب الصوفية، فيقول عن ذلك التوحيدي في المخاطبات: “يا عبد لا تنطق، فمن وصل لا ينطق”. هذا المنحى لا يختلف عمّا تواضع على تسميته بالديانات الأرضية كالطاوية والكونفوشية على سبيل المثال، فهي ترى بالصمت الرحم الذي تولد منه الكلمات، فالتناوب بين الصمت والكلام، هو ما يسمح بولادة الإبداع البشري، لأن تجسيد الصمت يكمن في العمل؛ والكلمة تنبع من الانشغال بالعمل والصمت الذي يرافقه. والصمت لدى سقراط يولّد الحقيقة لدى الآخرين عبر الإنصات لهم، ومن ثم مناقشتهم. ولا يختلف الأمر في التحليل النفسي حيث أكّد فرويد (3) على أهمية صمت المعالج النفسي الذي يسمح للمريض أن يكون حرّا بتداعياته وتحرير مكبوتاته ممّا يساعد بالشفاء.
للحيطان آذان
ليس من تفضيل بين الكلام والصمت، فكلاهما لا يقوم له وجود من دون الآخر، فإذا كانت الآلهة خلقت الكون بالكلمة، فإنها تركت لنا الإشارة والنُّصبَة – المعدودتين من ملامح الصمت- من سماء، وبحر، وجبال، ووديان، ومخلوقات تدب وتطير في الطبيعة، دليلًا على كلمتها الخالقة.
لكن الديكتاتوريات استنسخت سلطة الكلمة الإلهية بما يخدم مصالحها، فالتحكّم بالصمت والكلمة من قبلها يهدف إلى قمع أية مساءلة توجّه نحوها. وكما كتب جورج أورويل في روايته 1984، بأن سلطة الأخ الأكبر عملت على بسترة اللغة، بحيث نزعت منها كل الكلمات التي من الممكن أن تشكل مهدًا للتفكير بالثورة. ومن جهة ثانية راقبت الصمت حتى لا يختلي الإنسان بأفكاره الخاصة، فقمع الكلمة لا يختلف عن قمع الصمت، فالكلمة الحرّة تستدعي مقابلها صمتًا حرًّا. وعندما يفقدهما الإنسان معًا يتحوّل إلى رقم في مكنة تمجيد الديكتاتور.
يقول أحد الأدباء الغربيين: “يملك الصمت هيكله الخاص ومتاهاته الخاصة، كما تناقضاته الخاصة. صمت القاتل، ليس هو صمت الضحية، وليس هو صمت المتفرج”. إذًا للصمت أنماط، فالصمت عندما تقتل الكلمة يصبح هو الكلمة، فللضحية صمتها الذي يعني مقاومتها. وصمت المتفرج هو إشهار لخذلانه، أمّا صمت القاتل، فهو العوز الكامن فيه أن يكون صاحب كلمة.
إنّ العودة إلى التكلّم عن الصمت في زمننا الحالي تكمن أهميته في ازدياد غربة الإنسان عن نفسه، أمام التكلّم الذي لا يتوقف، والذي أنتجته ثورة الاتصالات والعولمة والسوشيال ميديا، فإن كان الإنسان حيوانًا ناطقًا وفق تعريف أرسطو، فلا تتم إنسانيته إلا إذا كان قادرًا على الصمت النابع من ذاته بعيدًا عن أية أدلجة، فصيغة الصمت المشتهاة تتقاطع مع الكلمة السنسكريتية شانتام/Shantam والتي تعني السلام والهدوء، حيث ينبع الصوت/ الكلمة من قلب الصمت ويزهر الصمت في تربة الكلام.
يكاد الفيلسوف ماكس بيكارد (4) أن يكون ناعيًا للصمت في زمننا الحديث المليء بالضجيج، فالصمت الذي احتفي به في الأزمنة القديمة كطريق للسلام والسكينة والتبصر لم يعد موجودًا، فهناك فيض لا ينتهي من الأصوات والكلام يطرد الصمت إلى جزر قصيّة في داخل الإنسان. يرى بيكارد الصمت هو الناجي الوحيد من الحداثة والتسليع الرأسمالي، وهذه النجاة بقدر ما هي إيجابية، إلا أنها تكشف تواري الصمت عن مسرح التكلم الذي لا يتوقف، وكأن الإنصات لم يكن يومًا صدى الصوت. لم يشهد بيكارد زمن العولمة وثورة الاتصالات الذي نعيشه حاليًا حيث الضجيج الذي ينتجه الإنسان لا يتوقف أبدًا. فالنشاط الإنساني الصائت يتصادى وفق تعبير لوبروطون بين مشرق الأرض ومغربها ملغيًا فكرة الصمت من حسابه، لكن أمام هذا الضجيج الإنساني ظهرت الحاجة الملحة من جديد إلى الصمت، والمناداة باعتباره حقًا من حقوق الإنسان، وأنه سلعة مطلوبة ونادرة، فالآلات المضجة، ووسائل السمعي والمرئي، ونشاط الإنسان أصبحت أعلى تقييمًا إن كانت تعمل بصمت ومن دون إزعاج الآخرين. وأمام هذه الحاجة الملحَّة لتواجد الصمت، أصبح من الضرورة إعادة تأصيله بتاريخه المنسي كي لا يتحوّل إلى مجرد كمالية تلحق بزمن الضجيج الذي نعيشه حاليًا.
“مقتل الرجل بين فكيه”…
هذه الجملة تعود إلى الحكيم الجاهلي أكثم بن صيفي، فالحذر من الكلمة يعود إلى أنها تصيب مقتلًا، وقد تؤدي إلى هلاك صاحبها. لقد اُحتفي بالصمت في التراث العربي بشكل كبير حتى كاد يظن بأنه قد فضّل على الكلمة من أهل البيان، حيث نجد في المجاميع التراثية كالعقد الفريد عند ابن عبد ربه الذي يفرد بابًا للصمت. وعند ابن أبي الدنيا كتاب عن آداب الصمت وآداب اللسان. ولربما أكثر من اعتنى بالصمت هم الصوفية، وهذا حق لهم أمام الحضرة الإلهية، لكن أن يصبح الصمت بديلًا عن الكلمة بالمطلق، فهذا ما لم يقبله الجاحظ صاحب “البيان والتبيين”، ورسالته في تفضيل الناطق على الصامت. وتأتي قصته عن عبد الله بن سوار مع الذباب (5) كاشفة عن تهافت الصمت، إن لم يكن في محله، فعبد الله بن سوار كان قاضيًا التزم الصمت شكلًا ومعنى، حيث كان يجلس كالصنم، ولا تخرج منه الكلمة إلا بشق النفس. وهذا لا يجوز منه، وهو المطلوب منه بيان الحقوق ورفع المظالم وإيضاح الأسباب، فأرسل الله له ذبابة تهتك صمته المفتعل، وتؤكّد أن الساكت عن الحق شيطان أخرس.
أهل الصمت
ليس ارتباط الحب بالصمت بالضرورة خوفًا من العذال أو سطوة التحريمات المجتمعية، بل يأتي من تجلي الصمت في مقابل الكلام كصوت وصداه، فإنصات الحبيب للمحِّب يجعل الصمت مسموعًا ومحسوسًا. وكما يقول ماكس بيكارد: “هناك صمت أكثر من اللغة في الحب” مع أن تاريخ العشق قد نُقل لنا عبر الكلمة، فالمدقّق في قصص الحب يرى أن المسكوت عنه أكثر ممّا قيل. والسبب يعود إلى أن كل الأشياء تأخذ من الصمت شيئًا ما عدا الحب، فإنه يمنح الصمت بعضًا منه؛ وهو ما يبقى للعاشقين في سريرتهم غير قابل للتداول اللساني. يقول كثيرة عزة:
لعمري ما استودعت سري وسرها/ سوانا حذار أن تشيع السرائر
ولا خاطبتها مقلتاي بنظرة/ فتعلم نجوانا العيون النواظر
ولكني جعلت اللحظ بيني وبينها/ رسولا فأدى ما تجن الضمائر.
إنّ السّرّ الشقيق التوأم للصمت، وهذا ما يقوله العباس بن الأحنف:
إشارتنا في الحب غمز عيوننا/ وكل لبيب بالإشارة يفهم
حواجبنا تقضي الحوائج بيننا/ ونحن سكوت والهوى يتكلم.
وكأن الشاعر المحِّب يستغني عن السير الطبيعي للتواصل الإنساني عبر الكلمة، ويذهب إلى الإشارة والنُّصبة لإظهار مكنون حبّه عبر الصمت والاستسرار. يقول باسكال: “الصمت في الحب أفضل بكثير من الكلام؛ فمن الأفضل تحريمه، ثمة فصاحة للصمت تلج البواطن أفضل مما يمكن للغة أن تفعله”. وكأن الحب وفق باسكال يستغني عن أدوات التواصل وخاصة اللغوية، وذلك لأنه غدا التواصل ذاته، حيث تنقلب الأدوار ويصبح الكلام أداة للحب/ الصمت. ألم يقل نزار قباني: “كلماتنا في الحب تقتل حبنا، إن الحروف تموت حين تقال”. تحكي الأسطورة عن كيوبيد أنه إله العشق الصغير الذي يرشق بسهامه قلوب المحبين، ومع ذلك فقدته عشيقته بسايكي عندما أشعلت شمعة لتراه، فالرؤية تعادل الكلام/ إفشاء السر، ألم يقل أرسطو: “تكلم كي أراك”، لقد نقضت بسايكي قانون الحب/ الصمت، لذلك هرب كيوبيد. ارتبط الحب بالموت، لأن كلًا منهما هو صمت كبير، لذلك نلحظ في المجاميع التراثية التي تناولت موضع العشق في التراث العربي، بأن الموت هو النهاية الحتمية للعشاق، وخاصة العذريين الذين كانوا يضنّون بالبوح بمشاعرهم ويلزمون الصمت حتى يموتون. ولهذا كانت العرب تقول: “المحب إذا سكت هلك”، ولكن العشاق يعلمون عندما يصبح الحب في مدار الكلام، فإنه قد أصبح شأنًا عاديًا.
كانت شهرزاد تنهي كل قصة بالصمت: “وسكتت شهرزاد عن الكلام المباح”، فلولا هذا الصمت الذي كان يقطع سيرورة الحكاية لم تكن “ألف ليلة وليلة”، فإذا كان الكلام لا يُعقل بالصمت والإنصات، فهو لغو. وإذا كان الصمت لا يتوّج بالكلمة، فهو أنسب للجماد. وقد عنونّا هذا المقال بأن الصمت حمّال أوجه، وأحد أوجهه هو الكلمة.
الهوامش والمصادر:
1- النُّصْبَة: هي الحال الناطقة بغير اللفظ والمشيرة بغير اليد.
2- مغامرة العقل الأولى، دراسة في الأسطورة: سوريا وبلاد الرافدين، فراس السواح، الناشر: مؤسسة هنداوي 2017.
3- الصمت، لغة المعنى والوجود، دافيد لوبروطون. المركز الثقافي للكتاب – المغرب 2019.
4- عالم الصمت، ماكس بيكارد. دار التنوير 2018.
5- الحيوان، الجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون، الناشر مصطفى البابي الحلبي 1965.

February 28, 2023
مقهى الأشباح. قصتي في مجلة العربية العدد 558 / مارس / 2023
هناك من يكلّم نفسه، كي يقنعها، بأنّه لا يعيش وحيدًا. وهناك من يربّي قطّة كي تؤنسه، مرجعًا الشعور بالإيناس لغويّا إلى الإنسان، حتى لو كان سببه حيوانًا أليفًا. وهناك من لا يجد أحدًا في وحدته، كالعجوز التي ألفت عزلتها، فالإنسان في الأصل يأتي إلى هذه الحياة وحيدًا ويخرج منها وحيدًا، فلماذا التذمّر، تقول لنفسها، وهي التي لم يحالفها الحظّ بأن يكون لها توأم يشاطرها الولادة ولربما الموت، أمّا عائلتها التي أفنت أجمل سنوات حياتها من أجلها، فقد شظّتها الأقدار المحتومة. كانت العجوز أحيانًا تستغرب ألفتها مع الوحدة التي آلت إليها حياتها، ولم يكن يبدّد هذه الغرابة أي تعليل خطر على ذهنها إلى أن اختمرت في قلبها فكرة، بأنّ الأشباح يظلّون معلّقين بين الحياة والموت، لأنّ أسبابهم لم تنقطع بعد من الحياة، فلا يطويهم الموت بين صفحاته حتى يستنفدوا أسباب تعلّقهم.
هذا التفسير الذي توصلت إليه العجوز، كان قد سُبق بعدّة حوادث مبهمة جرت معها، كأن لا تجد أدويتها، أو أدوات المطبخ في أمكنتها المعتادة. وعندما حاولت تعليل اختفاء تلك الأشياء، لم تعزها إلى كثرة النسيان الذي تعاني منه، بل أصابتها حالة من الغبطة حين حدست، بأنّ شبحًا ما قرّر أن يزورها. اندمجت العجوز سريعًا مع ضيفها، مزيلة تحفّظاتها العديدة نحو الغرباء بحيث سمحت له أن يمارس معها لعبة التخويف المحبّبة للأشباح، فأصبحت تصرخ بهلع عندما لا تجد نظارتها على أنفها، بل في إحدى المرطبانات، أو تصيبها الدهشة حتى الإغماء من ضياع فكّها، لتلقاه بين صور عائلتها على أحد الرفوف. وعندما تسري قشعريرة عبر فقرات ظهرها في ظلمة الليل تهمس للشبح: تصبح على خير، لقد حان وقت الأحلام.
في إحدى الأمسيات وبعد نقاش مطوّل مع الشبح، أقنعها بأن تعود إلى عملها القديم كنادلة، محوّلة بيتها الصغير إلى مقهى للأشباح، وهو سيتكفّل بإذاعة الخبر بين أشباح المدينة. تدفّق الأشباح سريعًا إلى مقهى العجوز، فأمست تقضي معظم ليلها تعدّ لهم المشروبات، وتستمع إلى أحاديثهم وشكاويهم، وتحلّ الخلافات الناشبة بينهم، فهم بشر أولًا وأخيرًا. سُرّت العجوز بعائلتها الجديدة من الأشباح، هؤلاء الأغراب الذين لا تربطهم بها صلة رحم أو قرابة، وحزنت لأجلهم عندما تأكّدت فكرتها، بأنّهم قد كانوا أناسًا وحيدين في حياتهم مثلها، لكنّهم مازالوا يأملون بلقاء شخص يهتم لأمرهم قبل أن يطويهم الموت، وهذا هو السبب في حالتهم البرزخية بين الحياة والموت، وهنا ساءلت العجوز نفسها، هل هي شبح؟ هذا التساؤل أوضح لها، لماذا كان العديد من الأشباح يختفون نهائيّا وبشكل مفاجىء بعد عدّة أشهر من ارتيادهم المقهى، مخلّفين وراءهم أنفاسًا تكاثفت كالضباب على زجاج النوافذ، فهي آخر آثارهم على هذه الأرض، بعدما وجدوا هذا الشخص، الذي حرّرهم من حالة وسطى بين الحياة والموت، والتي لم تكن يومًا فضيلة أبدًا.
كانت العجوز ما إن تنتهي ليلتها الصاخبة في خدمة الأشباح حتى تغرق في النوم متعبة، لكنّها سعيدة ومطمئنة على مستقبل عملها، فكلّ ليلة يأتي شبح جديد محتاجًا إلى آخر، وعطشًا للمشروبات وللثرثرة معها. وفي الصباح عندما تجد زجاج النوافذ قد أغبشته الأنفاس، تدرك بأنّ أحد الأشباح قد حرّره السهر في مقهاها. رضيت العجوز، بكلّ طيبة وحبّ أن تكون هذا الآخر، لكلّ شبح قدم إلى مقهاها، وتناست بأنّها هي الأخرى وحيدة وستحتاج إلى آخر عمّا قريب. في إحدى الليالي كانت العجوز مريضة جدًا، وقد تحلّق عدد من الأشباح من حولها، فاعتذرت منهم عن عدم قدرتها على خدمتهم، وقالت لهم، بأن يتصرّفوا على راحتهم، فهم من أهل البيت. مضى الليل صامتًا على المقهى، وفي الصباح كانت جميع نوافذ البيت قد غشيتها أنفاس الأشباح، ورويدًا رويدًا، بدّدت الشمس آخر العلامات التي تشي بأنّ أشباحًا قد أمضوا سهرتهم الأخيرة على هذه الأرض في مقهى العجوز. ظلّت النظارة التي نسيتها العجوز في البراد، تنتظر عينيها الدافئتين مع أنّ الشمس قد توسّطت قبة السماء. لقد ماتت العجوز، لكنّها لم تتحوّل إلى شبح على الرغم من الوحدة التي عاشتها في آخر أيام حياتها، فقد حملتها معها عائلتها الجديدة من الأشباح إلى السماء.
باسم سليمان
خاص العربية

February 13, 2023
الروائي الجزائري محمد بورحلة في قراءة عميقة وتناصية لروايتي جريمة في مسرح القباني. صحيفة الشعب الجزائرية
قراءة في رواية باسم سليمان “جريمة في مسرح القبّاني”،
منشورات دار ميم، الطبعة الأولى، الجزائر، 2020
فى الغلاف الخارجي، على خلفية ضاربة إلى البياض، جزء من ستارة مسرح حمراء. العنوان، مكتوب بالأحمر عنّابي، يتكلم عن جريمة وقعت بمسرح. تحته، رسم ليد مع خيط في كل إصبع. أشعر أنني متجه نحو نسخة ثانية من رواية “جريمة في قطار الشرق السريع”. أفتح الكتاب، بل النفق. عنوان فرعي يتحدث عن الحد والشبهة. يليه اقتباس من رينيه جيرارد، مهدى للسوريين في كل مكان، يجعل السلام هبة العنف. أقف عند المفارقة هنيهة، يحدّثني كلاوزفيتز ثم أعود إلى القراءة. في الحقيقة لا أقرأ، بل أتشبّث. سرد بصيغة المفرد الغائب. وصف دقيق لمكتب المحقق هشام بمبنى الجنائية بدمشق. يدور بخلده جدل عنيف خلّفه استعمال المبني للمجهول وموضوع الرؤيا الحلمية في قصة ابتلاء النبي إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام. استهلال على شكل علامات استفهام. كأن كل شيء قيل في المقدمة. الهاتف يرن. عميد يطلب من هشام التحقيق في جريمة وقعت في مسرح القباني أحد رواد المسرح بسوريا. لما تحرك ومساعده جميل ظننت أن بين يديّ رواية مثيرة لكنني كنت قاصدا متاهة مينوتور لا خيط أريادني لها.
المشتبه به، أحدب وأعرج، بائع كتب مستعملة في النهار. ليلا، يحرس مسرح القباني. يذكر المحقق بكواسيمودو، أحدب نوتردام، دميم رواية هوغو “نوتردام دي باريس”. الضحية جامع قمامة. وجهه وجسده مشوهان. تشوهات الاثنين ناتجة عن نفس الانفجار الإرهابي. أتذكر بودلير. في ديوانه “سآمة باريس” غنى الكلاب الموحلة والمصابة بالطاعون والمقمّلة. الزبال محرك عرائس، متكلم من بطنه وكاتب مسرحي. كان يتمنى أن يقدم مونودراما على مسرح القباني تكون عبارة عن اعتراف دمية اسمها (الجثة) أمام منكر ونكير في القبر. قدم عرضه أمام الحارس وحده الذي تركه ليأتيه بالماء، فلما عاد وجده مستلقيا على خشبة المسرح تحبط به الدمى. المسخ يمثل الضحية القربانية بامتياز ؛ فهو يمكّن المجتمع، من غير أن يطال هذا الأخير عقاب، من تحرير مكبوتاته واحتواء عنفه. كبش الفداء أفضل مخرج من معضلات الخير والشر، وأنفع علاج لأدواء الضمير. لكن لم المسرح؟ لا شك أنه من الضروري له أن يواجه فيه الجمهور وأن يظهر هناك، لأولئك الذين يغطون في نوم الاغتراب، الإنسان المنفصل عن نفسه، الممزق، المتصدع، المفكك، المنكر فرادته، المشكوك فيه، والمعرض للقذف علنا من غير تبعات. ولماذا الدمى؟ لأنها أكثر ما يشبه الإنسان الذي تشيأ وأصبح مصيره بيد غيره. الدمية هي الكائن البشري الذي لم يعد ملكًا لنفسه، المحروم منها لأجل أسباب عدة منها غريزة القطيع، السلوك التأسّلي، المنفعة السيادية، العنجهية أو السذاجة. إن الدمية كذلك أداة لتطهير الذات وإطلاق سراح المحبوس وتحرير الكلمة بالتحايل على الخجل والرقابة وهي أيضا أسلوب يعبر عن محاولة وضع حد للعنف القرباني بإنهاء الرغبة المحاكاتية التي تسببت فيه. إن القتل فعل مدان بالأخلاق والقانون، والدمية، التي تمثله على الركح تسمح للمشاهد التخلص من شروره. الجمهور يقتل بواسطة دمية لكن لن يعاقب ويمكنه، في نهاية العرض، العودة إلى قوقعته مرتاح الضمير. الدميم، بعد ما بلغ سيل خيباته الزبى، وجد نفسه مضطرا من قبل عالم سخيف أين فقد ظله وجفّ نسغه ولم يصبح له من الممكن سماع صوته أو إسماعه، لصنع دمية يحملّها الذنوب لوضع حد لطقس الفارماكوس. يمثل جيبيتو، الذي يتلألأ مخبره جمالا، الحلاج، أو المسيح كما يراه رينيه جيرارد، في العصر الحديث… عهد الكذب والكبر، زمن التلاعب والفئات القابلة للتضحية. أظن أنه لو شهد فيلم “التطهير الأول”، لأصابه اليأس. لكن ماذا لو كان يلجأ إلى الدمى إلا ليظهر كم نحن مثيرون للشفقة والسخرية؟
الحكي يلجأ إلى الشخصيات الحقيقية كالمحامي هائل اليوسفي. كثيرا ما يجبرني على التوقف والبحث. سيتعب القارئ، لكن تلك هي نزوات نص دسم إلى حد التخمة أو القلص. الانحرافات تبدو خارجة عن السياق لكنها استمرارية في التأمل في تيمات الفداء والضحية القربانية لأن العلاقة وطيدة بين قصتي إسماعيل الذبيح وراسكولينكوف، شخصية رواية “الجريمة والعقاب” لدوستويفسكي، الذي يبلغ الطهارة بدفع ثمن جريمته. هل أكون أمام رواية بوليسية ونفسية ؛ ألا يذكر الراوي الغائب أجاثا كريستي… أليس بعض شخصيات الرواية مستوحاة من مسلسل بوليسي سوري ناجح وأن هشام وجميل من شخصياته ؟ لكنني لا أشاهد تشويقا من شأنه أن يبقي القارئ معلقا ولا دافعا أو أسلوبا للقيام بالجريمة، ولا مجرمًا حتى. وأما الاستطرادات الكثيرة، فإنها تخرق قاعدة وحدة الحدث وتشتت الحبكة كما أن المحقق لا ينسى فقط مهمته (التحقيق والتحليل) بل يزيد لطين الغموض بلة بتساؤلاته المتتالية. يبدو أن الكاتب باسم سليمان يكتب هنا، عن قصد على الأرجح، نقيض الرواية البوليسية… كما يبدو أن كشف ألغاز الرواية سيتطلب أكثر من شرلوك هولمز وهيركيول بوارو مجتمعين. أفق التوقع الذي صنعاه العنوان والمؤشر الأجناسي ينتهي ببعض الخيبة إذ أن النص لا هو ينتمي تماما إلى الرواية ولا هو يخضع لشروط العمل البوليسي. لا أخفي حيرتي. كان من المفترض أن تكون رواية، وكان لدي فهم مسبق لها. أجد نفسي في زوبعة من الأجناس والإيحاءات. هل يمكن أن تكون الرواية عملاً تجريبيًا طلائعيًا؟ هل يعكس الانتقال بين الأجناس رفضا لقانون أو أنه يعبر عن الرغبة في استكشاف أراض مجهولة، وقيادة القارئ هناك… أم أنه يجسد عدم الثقة في شكل معين لأنه يشبه قيدا… أم هو يظهر إفلاس الأشكال والأنساق الذي يتبع سقوط عالم مهترئ، فيقتضي بالتالي المرور إلى الهدم وألوان تعبير مغايرة ولغة أخرى يسودها القلق والريب عوض السكينة ودفء المألوف. بالطبع، كيف يمكن للأدب أن يحافظ على أشكاله القديمة ويمنعها من التشظي في بلد اكتنفت ساحته الهموم وجاءت المآسي فيه تترى!
طريقة الكتابة أنستني الحبكة إن كانت هناك حبكة! حتى المحقق يتضح أنه لا يكترث لتحقيقه. الأوراق التي تركتها الضحية تهمه، ولكن ليس للعثور على الجاني بل لمشاركة محرك الدمى – توأمه – في ألمه الوجودي. النص ثقيل، مليء بالإيحاءات والمثاقفة. الراوي العليم يرافق قصته بالحواشي. لعله والمحقق شخص واحد. معظم الشخصيات لها نفس اللغة مما يعتبر خروجا عن مبدأ الاحتمالية. هل يمكن أن يفسَّر توحيد اللغة، وحتى الفكر، للشخصيات المختلفة بولادتها من ذهان وهذيان سردي لشخصية واحدة؟ هل يمكن أن يكون جميل الذي لا نعرف عنه شيئًا والذي يظهر في نهاية الرواية أنه راويها؟ المؤلف يطمس الآثار، ويحرك الخيوط بامتياز. كثرت الأسماء ولم أعد أعرف من يوجد أمامي بيكيت، غسان كنفاني، تشارلز سيميك أم طيف جيرارد؟ وتعدّدت الأماكن ولم أعد أعرف إن كنت في الجحيم أم في جنة ديلمون أم أمام جسر الرئيس حتى أنني لما تهت واعتقدت أن الحل في التقمص الوجداني “ركبت” المحقق ومساعده والمسخ لكنني لم أبلغ غور أحدهم، فعدت إلى حيرتي خالي الوفاض. أتذكر يونسكو ، “في انتظار جودو”… لوتريامون الذي كتب: “الآهات الشعرية لهذا القرن مغالطات”. إلى أي جنس يمكن أن تنتمي الرواية ؛ هل أراد المؤلف أن يجعل من نظريات رينيه جيرارد موضوع روايته كما جعل زولا، من قبل، نظريات داروين، إيبوليت تين وكلود برنارد مصدر تأمله للوراثة؟ عاشت سوريا، وما جاورها، مآسي قد لا تخطر ببال، فكيف لا يؤثر ذلك على أي مؤلف، وكيف يمكن للأدب أن يخرج سالماً من هذه القطائع العنيفة، فيحافظ على أشكال التعبير القديمة ويمنعها من الانفجار والخروج من فراش العادة ثم الذهاب إلى شواطئ أخرى حيث يسود القلق وإن اتسم النص، على حساب نية التواصل، بالغموض فيربك القراء العاديين والنقاد ويثير خيبتهم أو حفيظتهم ! العكس كان يكون غريبا ومفاجئا!
يبدو أن نيتشه وبينيديتو كروتشه يقدمان تفسيرا للغَول الذي أصابني و، في نفس الوقت، لأسلوب المؤلف. كتب الأول: “أي روح مميزة بعض الشيء، وأي ذوق يتسم ببعض الرقة يختار مستمعيه ؛ باختيارهم يغلق الباب أمام الآخرين”. فباختياره “طبلة الآذان القريبة” يشهر الكاتب فرادته ورهاناته. أما الثاني، فقد نبّه على أن: “كل تحفة حقيقية انتهكت قانون جنس راسخ، وبثت الفوضى في أذهان النقاد”. بانتقائه هذا الأسلوب، يبشر الكاتب بموسم الهدم، وبالرياح الجديدة التي تحمل روايته ويحملها الأدب العربي. لكن… هل هناك حقا ما يدعو للعجب في هذه الرواية؟ في بلدان نخبتها مصابة بحصر في جهازها الفكري، ومن لم يمت فيها من القنوط مات من الضجر… في بلدان – أو بالأحرى في قبائل أو بطون أو أفخاذ – يكشف فيها المستقبل بالأزلام وتبنى المدارس والحداثة على نمط السجون، وبالعصي… العبث يتغنج والعقل يتوارى والكلام يخاتل وإذا ما جنّ الليل، ينعم الناس بسلم المقابر. في بلدان تتهاوى مسلماتها في ضوضاء مفزعة، لا ينافس السياسيين في زيفهم إلا الفنانون والأدباء، وتتوافد الأقلام على الأدب في دكاكين الهذر حيث يحتفى بقصائد النهود والأرداف وبشعر له نكهة النعي، “بين القريض والرقى”. في مثل هذه البلدان أين يعيش الناس بين قطع القلفة وختن اللسان، بين الاحتباس والسلس، ولا يطرق باب الجرأة التي تُخرج من طور العجي إلا غريبو الأطوار، فهل يكون من جدوى لأدب يرسف في أغلال العادة، لا يحس بالزلزال ولا تعكس متونه آثاره؟ لم العجب إذاً من رواية يتشظى فيها السرد وتتداخل الأجناس وتستأثر بالفكر والوعي الدمى؟
محمد بورحلة
09 فيفري 2023
نسخة باللغة الفرنسية
Lecture du roman « Crime au théâtre d’El Qabbani » de Bassem
Souleymane, Ed. MIM, première édition, Alger, 2020
Ce roman est, pour plusieurs raisons, déconcertant. En première de couverture, sur fond blanc sale, un pan de rideau de scène rouge. Au dessous du titre, écrit en grenat et évoquant un crime, le croquis d’une main avec des fils à chaque doigt. Des idées disparates traversent mon esprit. Je ressens la manipulation, j’éprouve des impressions de mystère. Vais-je au devant d’une variante du “crime de l’Orient Express”? Un sous-titre, parlant de sanction et de soupçon, est suivi d’une citation de René Girard dédiée aux Syriens où qu’ils soient. Hors contexte, cet énoncé qui fait de la paix un don de la violence est pour ceux qui n’en connaissent pas l’auteur d’une ambiguïté certaine. Je pense à Clausewitz. Je lis ; je m’accroche, devrais-je dire. Une narration à la troisième personne du singulier. Description balzacienne d’un bureau à la criminelle de Damas, celui de l’inspecteur Hicham. Le téléphone sonne. Sa hiérarchie l’informe qu’un crime a été commis dans un lieu réputé de Damas : le théâtre d’El-Qabbani, du nom de l’un des « pères » du théâtre syrien. On lui demande d’enquêter. Sur la scène – au sens propre et figuré – du crime gît un homme. Il semble, à ce qu’il paraît, avoir été assassiné par ses marionnettes. Un polar, me suis-je dit. J’allais vite déchanter. Pour démêler l’écheveau, il fallait bien plus que Sherlock Holmes et Hercule Poirot réunis.
Le suspect est un bouquiniste. La nuit, il est veilleur au théâtre d’El-Qabbani. C’est un bossu qui boite. Il rappelle à Hicham « Quasimodo », le personnage du roman de Victor Hugo, « Notre-Dame de Paris ». La victime est un éboueur ; son visage et son corps sont défigurés. Leurs déformations sont dues au même attentat terroriste. Je me rappelle Baudelaire. Dans « Le spleen de Paris », il chantait les chiens crottés, les pestiférés et les pouilleux. Le balayeur représente la victime sacrificielle par excellence. La société peut se défouler sur lui en toute impunité afin de contenir sa violence et se blanchir. Le bouc émissaire est la meilleure des casuistiques. C’est un marionnettiste ventriloque et un dramaturge. Mais pourquoi le théâtre ? Sans doute parce qu’il est vital pour lui de faire face au public et d’y montrer l’homme coupé de lui-même, écartelé, disloqué, nié dans son individualité, pointé du doigt, voué aux gémonies, tentant péniblement de se réapproprier sa propre vie. Mais pourquoi aussi la marionnette ? Parce que c’est ce qui ressemble le plus à l’homme qui subit l’histoire ! C’est l’homme qui ne s’appartient plus, privé de lui-même pour cause d’instinct grégaire, de norme atavique, d’utilité régalienne ou de suffisance. C’est aussi un outil cathartique. Elle permet d’extérioriser les traumatismes, de libérer le refoulé, la parole et, enfin, de tenter de mettre un terme à la violence sacrificielle en mettant fin au désir mimétique. La marionnette qui tue est la représentation sur scène d’un acte, condamné par la morale et la loi, qui permet au spectateur le défoulement. Le public tue par marionnette interposée ; il peut retourner chez lui purgé de ses passions. Aristote peut applaudir. Le marionnettiste est contraint par un monde où il ne se retrouve plus, où sa voix ne s’entend plus, à se fabriquer une poupée pour la charger de tous les péchés et mettre fin au pharmakos. Serait-il un Christ, ou un Halladj, des temps modernes, ceux du mensonge, de la déraison et des catégories victimaires qui leur sont consubstantielles ? Il aurait dû voir le film « La première purge » ; peut-être aurait-il changé de stratégie. Et si Gepetto recourrait aux poupées pour montrer, simplement, combien sommes-nous pitoyables, de vrais histrions, même pas du niveau des pantins ?
Le récit m’oblige à décrocher, me documenter. C’est épuisant, mais il faut mériter le texte. Malgré les digressions, il y a une continuité dans la réflexion sur la rédemption, la victime sacrificielle, et entre l’histoire du sacrifice d’Ismaël et le Raskolnikov de “Crime et châtiment” qui accède à la purification en payant pour son crime, le rapport est réel. Aurais-je devant moi un roman policier et psychologique; le narrateur absent ne cite-t-il pas Agatha Christie ; le roman de Dostoïevski ne fut-il pas réceptionné comme tel par le public ? Pourtant, je n’y vois pas de clifhanger me tenant en haleine, de mobile, de mode opératoire du crime ni de criminel. L’auteur syrien – Bassem Souleymane – écrit ici, sans doute à dessein, l’antithèse du roman policier. Serait-ce un roman à thèse car l’ombre de René Girard porte le texte. S’inspirant de ses théories, Il semble que l’auteur ait voulu faire du désir mimétique le thème de son récit comme Zola, s’inspirant de celles de Darwin, Taine et Claude Bernard, le fit pour l’hérédité ?
La façon d’écrire me fait oublier l’intrigue. Si intrigue il y a ! Même l’inspecteur semble ne pas s’en préoccuper. Les écrits laissés par la victime l’intéressent au plus haut point. Ce n’est pas pour rechercher le coupable mais pour partager l’angoisse existentielle du marionnettiste, son double. Le texte est truffé d’allusions ; l’interculturalité est partout. Le narrateur, omniscient, accompagne son récit d’apostilles. Il paraît faire une seule personne avec l’enquêteur. La plupart des personnages ont le même parler ; une entorse de taille au principe de la vraisemblance, à l’arc dramatique. L’explication à l’uniformité de langage, voire de pensée, des différents protagonistes résiderait-elle dans le fait qu’elle naîtrait de la psychose et du délire narratif d’un seul personnage ? Serait-ce Djamil, l’assistant de Hicham, ce personnage dont on ne sait rien et dont on apprend en fin de roman qu’il en le narrateur ? L’auteur brouille les pistes, tire les ficelles. Certains de ses personnages sont inspirés d’un feuilleton policier syrien à succès. Hichem et Djamil en font partie ; l’auteur du feuilleton – personnage réel – vient solliciter la collaboration du policier. L’horizon d’attente suscitée par l’annonce générique en première de couverture se voile. Cela devait être un roman. J’en avais une précompréhension ; je ne cache pas mon trouble. Je me rappelle Ionesco, “En attendant Godot”… Lautréamont qui écrivit : « Les gémissements poétiques de ce siècle sont des sophismes ». A quel genre pourrait-il appartenir ; serait-ce une œuvre expérimentale? Le passage d’un genre à un autre traduirait-il la défiance à l’égard d’une forme assimilée à une contrainte et son refus, exprimerait-il le désir d’explorer des terres inconnues et d’y entraîner le lecteur ? La Syrie, voire le Moyen-Orient, ayant été victime d’une tragédie inouïe, comment cela pourrait-il ne pas impacter l’auteur et comment la littérature pourrait-elle en sortir indemne et empêcher ses anciennes formes d’expression d’exploser et sortir du lit de l’habitude puis aller vers d’autres rives où l’angoisse de la survie en tant qu’objet l’emporterait, même au risque de paraître abscons, de décevoir le lecteur et ne pas répondre à son attente, sur l’intention de communiquer ! Le contraire aurait été étonnant ! Nietzche et Benedetto Croce semblent donner raison à l’auteur. Le premier écrivait : “Tout esprit un peu distingué, tout goût un peu relevé choisit ses auditeurs; les choisissant il ferme la porte aux autres”. Le second constatait que: « tout véritable chef-d’œuvre a violé la loi d’un genre établi, semant ainsi le désarroi dans l’esprit des critiques ». En choisissant les tympans qui lui sont parents, Bassem Souleymane annonce bien les vents nouveaux que porte la littérature arabe.
Mohamed Bourahla 09 février 2023

الروائي الجزائري محمد بورحلة في قراءة عميقة وتناصية لروايتي جريمة في مسرح القباني.
قراءة في رواية باسم سليمان “جريمة في مسرح القبّاني”،
منشورات دار ميم، الطبعة الأولى، الجزائر، 2020
فى الغلاف الخارجي، على خلفية ضاربة إلى البياض، جزء من ستارة مسرح حمراء. العنوان، مكتوب بالأحمر عنّابي، يتكلم عن جريمة وقعت بمسرح. تحته، رسم ليد مع خيط في كل إصبع. أشعر أنني متجه نحو نسخة ثانية من رواية “جريمة في قطار الشرق السريع”. أفتح الكتاب، بل النفق. عنوان فرعي يتحدث عن الحد والشبهة. يليه اقتباس من رينيه جيرارد، مهدى للسوريين في كل مكان، يجعل السلام هبة العنف. أقف عند المفارقة هنيهة، يحدّثني كلاوزفيتز ثم أعود إلى القراءة. في الحقيقة لا أقرأ، بل أتشبّث. سرد بصيغة المفرد الغائب. وصف دقيق لمكتب المحقق هشام بمبنى الجنائية بدمشق. يدور بخلده جدل عنيف خلّفه استعمال المبني للمجهول وموضوع الرؤيا الحلمية في قصة ابتلاء النبي إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام. استهلال على شكل علامات استفهام. كأن كل شيء قيل في المقدمة. الهاتف يرن. عميد يطلب من هشام التحقيق في جريمة وقعت في مسرح القباني أحد رواد المسرح بسوريا. لما تحرك ومساعده جميل ظننت أن بين يديّ رواية مثيرة لكنني كنت قاصدا متاهة مينوتور لا خيط أريادني لها.
المشتبه به، أحدب وأعرج، بائع كتب مستعملة في النهار. ليلا، يحرس مسرح القباني. يذكر المحقق بكواسيمودو، أحدب نوتردام، دميم رواية هوغو “نوتردام دي باريس”. الضحية جامع قمامة. وجهه وجسده مشوهان. تشوهات الاثنين ناتجة عن نفس الانفجار الإرهابي. أتذكر بودلير. في ديوانه “سآمة باريس” غنى الكلاب الموحلة والمصابة بالطاعون والمقمّلة. الزبال محرك عرائس، متكلم من بطنه وكاتب مسرحي. كان يتمنى أن يقدم مونودراما على مسرح القباني تكون عبارة عن اعتراف دمية اسمها (الجثة) أمام منكر ونكير في القبر. قدم عرضه أمام الحارس وحده الذي تركه ليأتيه بالماء، فلما عاد وجده مستلقيا على خشبة المسرح تحبط به الدمى. المسخ يمثل الضحية القربانية بامتياز ؛ فهو يمكّن المجتمع، من غير أن يطال هذا الأخير عقاب، من تحرير مكبوتاته واحتواء عنفه. كبش الفداء أفضل مخرج من معضلات الخير والشر، وأنفع علاج لأدواء الضمير. لكن لم المسرح؟ لا شك أنه من الضروري له أن يواجه فيه الجمهور وأن يظهر هناك، لأولئك الذين يغطون في نوم الاغتراب، الإنسان المنفصل عن نفسه، الممزق، المتصدع، المفكك، المنكر فرادته، المشكوك فيه، والمعرض للقذف علنا من غير تبعات. ولماذا الدمى؟ لأنها أكثر ما يشبه الإنسان الذي تشيأ وأصبح مصيره بيد غيره. الدمية هي الكائن البشري الذي لم يعد ملكًا لنفسه، المحروم منها لأجل أسباب عدة منها غريزة القطيع، السلوك التأسّلي، المنفعة السيادية، العنجهية أو السذاجة. إن الدمية كذلك أداة لتطهير الذات وإطلاق سراح المحبوس وتحرير الكلمة بالتحايل على الخجل والرقابة وهي أيضا أسلوب يعبر عن محاولة وضع حد للعنف القرباني بإنهاء الرغبة المحاكاتية التي تسببت فيه. إن القتل فعل مدان بالأخلاق والقانون، والدمية، التي تمثله على الركح تسمح للمشاهد التخلص من شروره. الجمهور يقتل بواسطة دمية لكن لن يعاقب ويمكنه، في نهاية العرض، العودة إلى قوقعته مرتاح الضمير. الدميم، بعد ما بلغ سيل خيباته الزبى، وجد نفسه مضطرا من قبل عالم سخيف أين فقد ظله وجفّ نسغه ولم يصبح له من الممكن سماع صوته أو إسماعه، لصنع دمية يحملّها الذنوب لوضع حد لطقس الفارماكوس. يمثل جيبيتو، الذي يتلألأ مخبره جمالا، الحلاج، أو المسيح كما يراه رينيه جيرارد، في العصر الحديث… عهد الكذب والكبر، زمن التلاعب والفئات القابلة للتضحية. أظن أنه لو شهد فيلم “التطهير الأول”، لأصابه اليأس. لكن ماذا لو كان يلجأ إلى الدمى إلا ليظهر كم نحن مثيرون للشفقة والسخرية؟
الحكي يلجأ إلى الشخصيات الحقيقية كالمحامي هائل اليوسفي. كثيرا ما يجبرني على التوقف والبحث. سيتعب القارئ، لكن تلك هي نزوات نص دسم إلى حد التخمة أو القلص. الانحرافات تبدو خارجة عن السياق لكنها استمرارية في التأمل في تيمات الفداء والضحية القربانية لأن العلاقة وطيدة بين قصتي إسماعيل الذبيح وراسكولينكوف، شخصية رواية “الجريمة والعقاب” لدوستويفسكي، الذي يبلغ الطهارة بدفع ثمن جريمته. هل أكون أمام رواية بوليسية ونفسية ؛ ألا يذكر الراوي الغائب أجاثا كريستي… أليس بعض شخصيات الرواية مستوحاة من مسلسل بوليسي سوري ناجح وأن هشام وجميل من شخصياته ؟ لكنني لا أشاهد تشويقا من شأنه أن يبقي القارئ معلقا ولا دافعا أو أسلوبا للقيام بالجريمة، ولا مجرمًا حتى. وأما الاستطرادات الكثيرة، فإنها تخرق قاعدة وحدة الحدث وتشتت الحبكة كما أن المحقق لا ينسى فقط مهمته (التحقيق والتحليل) بل يزيد لطين الغموض بلة بتساؤلاته المتتالية. يبدو أن الكاتب باسم سليمان يكتب هنا، عن قصد على الأرجح، نقيض الرواية البوليسية… كما يبدو أن كشف ألغاز الرواية سيتطلب أكثر من شرلوك هولمز وهيركيول بوارو مجتمعين. أفق التوقع الذي صنعاه العنوان والمؤشر الأجناسي ينتهي ببعض الخيبة إذ أن النص لا هو ينتمي تماما إلى الرواية ولا هو يخضع لشروط العمل البوليسي. لا أخفي حيرتي. كان من المفترض أن تكون رواية، وكان لدي فهم مسبق لها. أجد نفسي في زوبعة من الأجناس والإيحاءات. هل يمكن أن تكون الرواية عملاً تجريبيًا طلائعيًا؟ هل يعكس الانتقال بين الأجناس رفضا لقانون أو أنه يعبر عن الرغبة في استكشاف أراض مجهولة، وقيادة القارئ هناك… أم أنه يجسد عدم الثقة في شكل معين لأنه يشبه قيدا… أم هو يظهر إفلاس الأشكال والأنساق الذي يتبع سقوط عالم مهترئ، فيقتضي بالتالي المرور إلى الهدم وألوان تعبير مغايرة ولغة أخرى يسودها القلق والريب عوض السكينة ودفء المألوف. بالطبع، كيف يمكن للأدب أن يحافظ على أشكاله القديمة ويمنعها من التشظي في بلد اكتنفت ساحته الهموم وجاءت المآسي فيه تترى!
طريقة الكتابة أنستني الحبكة إن كانت هناك حبكة! حتى المحقق يتضح أنه لا يكترث لتحقيقه. الأوراق التي تركتها الضحية تهمه، ولكن ليس للعثور على الجاني بل لمشاركة محرك الدمى – توأمه – في ألمه الوجودي. النص ثقيل، مليء بالإيحاءات والمثاقفة. الراوي العليم يرافق قصته بالحواشي. لعله والمحقق شخص واحد. معظم الشخصيات لها نفس اللغة مما يعتبر خروجا عن مبدأ الاحتمالية. هل يمكن أن يفسَّر توحيد اللغة، وحتى الفكر، للشخصيات المختلفة بولادتها من ذهان وهذيان سردي لشخصية واحدة؟ هل يمكن أن يكون جميل الذي لا نعرف عنه شيئًا والذي يظهر في نهاية الرواية أنه راويها؟ المؤلف يطمس الآثار، ويحرك الخيوط بامتياز. كثرت الأسماء ولم أعد أعرف من يوجد أمامي بيكيت، غسان كنفاني، تشارلز سيميك أم طيف جيرارد؟ وتعدّدت الأماكن ولم أعد أعرف إن كنت في الجحيم أم في جنة ديلمون أم أمام جسر الرئيس حتى أنني لما تهت واعتقدت أن الحل في التقمص الوجداني “ركبت” المحقق ومساعده والمسخ لكنني لم أبلغ غور أحدهم، فعدت إلى حيرتي خالي الوفاض. أتذكر يونسكو ، “في انتظار جودو”… لوتريامون الذي كتب: “الآهات الشعرية لهذا القرن مغالطات”. إلى أي جنس يمكن أن تنتمي الرواية ؛ هل أراد المؤلف أن يجعل من نظريات رينيه جيرارد موضوع روايته كما جعل زولا، من قبل، نظريات داروين، إيبوليت تين وكلود برنارد مصدر تأمله للوراثة؟ عاشت سوريا، وما جاورها، مآسي قد لا تخطر ببال، فكيف لا يؤثر ذلك على أي مؤلف، وكيف يمكن للأدب أن يخرج سالماً من هذه القطائع العنيفة، فيحافظ على أشكال التعبير القديمة ويمنعها من الانفجار والخروج من فراش العادة ثم الذهاب إلى شواطئ أخرى حيث يسود القلق وإن اتسم النص، على حساب نية التواصل، بالغموض فيربك القراء العاديين والنقاد ويثير خيبتهم أو حفيظتهم ! العكس كان يكون غريبا ومفاجئا!
يبدو أن نيتشه وبينيديتو كروتشه يقدمان تفسيرا للغَول الذي أصابني و، في نفس الوقت، لأسلوب المؤلف. كتب الأول: “أي روح مميزة بعض الشيء، وأي ذوق يتسم ببعض الرقة يختار مستمعيه ؛ باختيارهم يغلق الباب أمام الآخرين”. فباختياره “طبلة الآذان القريبة” يشهر الكاتب فرادته ورهاناته. أما الثاني، فقد نبّه على أن: “كل تحفة حقيقية انتهكت قانون جنس راسخ، وبثت الفوضى في أذهان النقاد”. بانتقائه هذا الأسلوب، يبشر الكاتب بموسم الهدم، وبالرياح الجديدة التي تحمل روايته ويحملها الأدب العربي. لكن… هل هناك حقا ما يدعو للعجب في هذه الرواية؟ في بلدان نخبتها مصابة بحصر في جهازها الفكري، ومن لم يمت فيها من القنوط مات من الضجر… في بلدان – أو بالأحرى في قبائل أو بطون أو أفخاذ – يكشف فيها المستقبل بالأزلام وتبنى المدارس والحداثة على نمط السجون، وبالعصي… العبث يتغنج والعقل يتوارى والكلام يخاتل وإذا ما جنّ الليل، ينعم الناس بسلم المقابر. في بلدان تتهاوى مسلماتها في ضوضاء مفزعة، لا ينافس السياسيين في زيفهم إلا الفنانون والأدباء، وتتوافد الأقلام على الأدب في دكاكين الهذر حيث يحتفى بقصائد النهود والأرداف وبشعر له نكهة النعي، “بين القريض والرقى”. في مثل هذه البلدان أين يعيش الناس بين قطع القلفة وختن اللسان، بين الاحتباس والسلس، ولا يطرق باب الجرأة التي تُخرج من طور العجي إلا غريبو الأطوار، فهل يكون من جدوى لأدب يرسف في أغلال العادة، لا يحس بالزلزال ولا تعكس متونه آثاره؟ لم العجب إذاً من رواية يتشظى فيها السرد وتتداخل الأجناس وتستأثر بالفكر والوعي الدمى؟
محمد بورحلة
09 فيفري 2023
نسخة باللغة الفرنسية
Lecture du roman « Crime au théâtre d’El Qabbani » de Bassem
Souleymane, Ed. MIM, première édition, Alger, 2020
Ce roman est, pour plusieurs raisons, déconcertant. En première de couverture, sur fond blanc sale, un pan de rideau de scène rouge. Au dessous du titre, écrit en grenat et évoquant un crime, le croquis d’une main avec des fils à chaque doigt. Des idées disparates traversent mon esprit. Je ressens la manipulation, j’éprouve des impressions de mystère. Vais-je au devant d’une variante du “crime de l’Orient Express”? Un sous-titre, parlant de sanction et de soupçon, est suivi d’une citation de René Girard dédiée aux Syriens où qu’ils soient. Hors contexte, cet énoncé qui fait de la paix un don de la violence est pour ceux qui n’en connaissent pas l’auteur d’une ambiguïté certaine. Je pense à Clausewitz. Je lis ; je m’accroche, devrais-je dire. Une narration à la troisième personne du singulier. Description balzacienne d’un bureau à la criminelle de Damas, celui de l’inspecteur Hicham. Le téléphone sonne. Sa hiérarchie l’informe qu’un crime a été commis dans un lieu réputé de Damas : le théâtre d’El-Qabbani, du nom de l’un des « pères » du théâtre syrien. On lui demande d’enquêter. Sur la scène – au sens propre et figuré – du crime gît un homme. Il semble, à ce qu’il paraît, avoir été assassiné par ses marionnettes. Un polar, me suis-je dit. J’allais vite déchanter. Pour démêler l’écheveau, il fallait bien plus que Sherlock Holmes et Hercule Poirot réunis.
Le suspect est un bouquiniste. La nuit, il est veilleur au théâtre d’El-Qabbani. C’est un bossu qui boite. Il rappelle à Hicham « Quasimodo », le personnage du roman de Victor Hugo, « Notre-Dame de Paris ». La victime est un éboueur ; son visage et son corps sont défigurés. Leurs déformations sont dues au même attentat terroriste. Je me rappelle Baudelaire. Dans « Le spleen de Paris », il chantait les chiens crottés, les pestiférés et les pouilleux. Le balayeur représente la victime sacrificielle par excellence. La société peut se défouler sur lui en toute impunité afin de contenir sa violence et se blanchir. Le bouc émissaire est la meilleure des casuistiques. C’est un marionnettiste ventriloque et un dramaturge. Mais pourquoi le théâtre ? Sans doute parce qu’il est vital pour lui de faire face au public et d’y montrer l’homme coupé de lui-même, écartelé, disloqué, nié dans son individualité, pointé du doigt, voué aux gémonies, tentant péniblement de se réapproprier sa propre vie. Mais pourquoi aussi la marionnette ? Parce que c’est ce qui ressemble le plus à l’homme qui subit l’histoire ! C’est l’homme qui ne s’appartient plus, privé de lui-même pour cause d’instinct grégaire, de norme atavique, d’utilité régalienne ou de suffisance. C’est aussi un outil cathartique. Elle permet d’extérioriser les traumatismes, de libérer le refoulé, la parole et, enfin, de tenter de mettre un terme à la violence sacrificielle en mettant fin au désir mimétique. La marionnette qui tue est la représentation sur scène d’un acte, condamné par la morale et la loi, qui permet au spectateur le défoulement. Le public tue par marionnette interposée ; il peut retourner chez lui purgé de ses passions. Aristote peut applaudir. Le marionnettiste est contraint par un monde où il ne se retrouve plus, où sa voix ne s’entend plus, à se fabriquer une poupée pour la charger de tous les péchés et mettre fin au pharmakos. Serait-il un Christ, ou un Halladj, des temps modernes, ceux du mensonge, de la déraison et des catégories victimaires qui leur sont consubstantielles ? Il aurait dû voir le film « La première purge » ; peut-être aurait-il changé de stratégie. Et si Gepetto recourrait aux poupées pour montrer, simplement, combien sommes-nous pitoyables, de vrais histrions, même pas du niveau des pantins ?
Le récit m’oblige à décrocher, me documenter. C’est épuisant, mais il faut mériter le texte. Malgré les digressions, il y a une continuité dans la réflexion sur la rédemption, la victime sacrificielle, et entre l’histoire du sacrifice d’Ismaël et le Raskolnikov de “Crime et châtiment” qui accède à la purification en payant pour son crime, le rapport est réel. Aurais-je devant moi un roman policier et psychologique; le narrateur absent ne cite-t-il pas Agatha Christie ; le roman de Dostoïevski ne fut-il pas réceptionné comme tel par le public ? Pourtant, je n’y vois pas de clifhanger me tenant en haleine, de mobile, de mode opératoire du crime ni de criminel. L’auteur syrien – Bassem Souleymane – écrit ici, sans doute à dessein, l’antithèse du roman policier. Serait-ce un roman à thèse car l’ombre de René Girard porte le texte. S’inspirant de ses théories, Il semble que l’auteur ait voulu faire du désir mimétique le thème de son récit comme Zola, s’inspirant de celles de Darwin, Taine et Claude Bernard, le fit pour l’hérédité ?
La façon d’écrire me fait oublier l’intrigue. Si intrigue il y a ! Même l’inspecteur semble ne pas s’en préoccuper. Les écrits laissés par la victime l’intéressent au plus haut point. Ce n’est pas pour rechercher le coupable mais pour partager l’angoisse existentielle du marionnettiste, son double. Le texte est truffé d’allusions ; l’interculturalité est partout. Le narrateur, omniscient, accompagne son récit d’apostilles. Il paraît faire une seule personne avec l’enquêteur. La plupart des personnages ont le même parler ; une entorse de taille au principe de la vraisemblance, à l’arc dramatique. L’explication à l’uniformité de langage, voire de pensée, des différents protagonistes résiderait-elle dans le fait qu’elle naîtrait de la psychose et du délire narratif d’un seul personnage ? Serait-ce Djamil, l’assistant de Hicham, ce personnage dont on ne sait rien et dont on apprend en fin de roman qu’il en le narrateur ? L’auteur brouille les pistes, tire les ficelles. Certains de ses personnages sont inspirés d’un feuilleton policier syrien à succès. Hichem et Djamil en font partie ; l’auteur du feuilleton – personnage réel – vient solliciter la collaboration du policier. L’horizon d’attente suscitée par l’annonce générique en première de couverture se voile. Cela devait être un roman. J’en avais une précompréhension ; je ne cache pas mon trouble. Je me rappelle Ionesco, “En attendant Godot”… Lautréamont qui écrivit : « Les gémissements poétiques de ce siècle sont des sophismes ». A quel genre pourrait-il appartenir ; serait-ce une œuvre expérimentale? Le passage d’un genre à un autre traduirait-il la défiance à l’égard d’une forme assimilée à une contrainte et son refus, exprimerait-il le désir d’explorer des terres inconnues et d’y entraîner le lecteur ? La Syrie, voire le Moyen-Orient, ayant été victime d’une tragédie inouïe, comment cela pourrait-il ne pas impacter l’auteur et comment la littérature pourrait-elle en sortir indemne et empêcher ses anciennes formes d’expression d’exploser et sortir du lit de l’habitude puis aller vers d’autres rives où l’angoisse de la survie en tant qu’objet l’emporterait, même au risque de paraître abscons, de décevoir le lecteur et ne pas répondre à son attente, sur l’intention de communiquer ! Le contraire aurait été étonnant ! Nietzche et Benedetto Croce semblent donner raison à l’auteur. Le premier écrivait : “Tout esprit un peu distingué, tout goût un peu relevé choisit ses auditeurs; les choisissant il ferme la porte aux autres”. Le second constatait que: « tout véritable chef-d’œuvre a violé la loi d’un genre établi, semant ainsi le désarroi dans l’esprit des critiques ». En choisissant les tympans qui lui sont parents, Bassem Souleymane annonce bien les vents nouveaux que porte la littérature arabe.
Mohamed Bourahla 09 février 2023

February 11, 2023
سببها بعوضة وأوّلها حدثت يوم قُتل هابيل… الزلازل في التراث العربي
السبت 11 فبراير 202301:36 م
يقول أسامة بن منقذ: “لا ألتقي الدهرَ من بعد الزلازل ما/حييت، إلّا كسير القلب حيرانا”. هذا هو حال السوريين بعد أن عصفت بهم نار الحرب السوداء لتأتيهم بعد ذلك الطبيعة بزلزالها، فإن كسرت الحرب منهم العظم، فزلزال كهرمان مرعش الذي ضرب تركيا في ساعة مبكرة من صبيحة يوم الاثنين الموافق 6 شباط/فبراير عام 2023 وامتدّ إلى سوريا شظّى أرواحهم الهشّة في صبح مستطيل؛ وهو الصبح الكاذب، فمتى يتقد صبحكم المستطير بالنور والأمان أيّها السوريون؟
يعود أول مقياس للزلازل إلى الصين عام 132م، وكان يسمى جرّة التنين، وهو عبارة عن جرّة أسطوانية يخرج منها ثماني أذرع على شكل رؤوس التنانين وفي كل فم كرة. وتسقط الكرات تباعاً حسب شدّة الزلزال إلى أفواه ثمانية ضفادع. أمّا العرب فقد ذهبوا في تحديد شدّة الزلزال إلى قياس مدّته الزمنية، فيذكر الدواداري بأنّه في العام 702 هـ، قامت الأرض تهتزّ ربع ساعة فلكية، أو خمس درج في تقدير المقريزي، أي ما يعادل عشرين دقيقة؛ فيقولون وقعت في القاهرة زلزلة نصف درجة ولو دامت لأفسدت. أمّا عن قوة الزلزلة، فكانت توصف بالكلمات من قبيل: شديدة، هائلة، متوسطة، خفيفة. وفي زمننا الحالي يعتبر مقياس ريختر الأشهرَ في قياس شدّة الزلازل.
يذهب علماء الجيولوجيا في الكشف عن آثار الزلازل إلى التنقيب في طبقات الكرة الأرضية، ويدعمهم في هذا البحث ما جاء في كتب التاريخ من ذكر عنها. وتعتبر رسالة السيوطي “كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة“، من أهم المجاميع التراثية التي تذكر الزلازل في منطقتنا العربية. ولقد تنوّعت هذه المصادر ما بين ما يختصّ بالزلازل، حيث أورد ابن النديم في فهرسه كتاباً بعنوان “علم حدوث الرياح في باطن الأرض المحدثة كثير الزلازل” وهو للكِندي. ويعدّ أقدم مصدر عربي اختص بذكر الزلازل.
وذكر ياقوت الحموي في كتابه “معجم الأدباء” أن ابن عساكر كتب كتاباً من ثلاثة أجزاء بعنوان “الإنذار بحدوث الزلزال”. وهناك العديد من الكتب التي تناولت الزلزال بجانبه الفقهي والديني. وفي جانب آخر تناول الكتّاب العرب القدماء الزلازل ضمن كتبهم، كما فعل الطبري في “تاريخ الرسل والملوك”، و”الكامل في التاريخ” لابن كثير.
هذا الاهتمام بالزلازل من العرب قادهم إلى البحث في أسبابها، فمنهم من أرجعها إلى أسباب دينية وعقابية، ووضعها آخرون ضمن مخيال خرافي. أمّا البقية، فقد نحوا منحى طبيعياً في تفسيرها، ولقد بدأوا التسجيل من العام 20 هـ، في حين ربطوا الزلازل قبل البعثة النبوية بأحداث دينية متعلّق بولادة الأنبياء أو اضطهادهم.
يقول السيوطي بأن أول زلزلة في الأرض حدثت يوم قتل قابيل أخاه هابيل واستمرت سبعة أيام. وأورد بأنّ أرض الشام قد اهتزت بعد المسيح واحدة وثمانين مرة. ويذكر أنّ الأرض قد رجفت يوم مولد الرسول، وفيها سقطت أربع عشرة شرفة من إيوان كسرى. وحاول الفلكيون أن يتنبأوا بالزلازل، ويذكر العسقلاني ذلك، بأنّه عام 801 هـ ذكر أهل الهيئة بأنّه يقع في هذه السنة زلزال عظيم، في أول جمعة منها. وشاع بين الناس ذلك، لكن لم يقع شيء من ذلك وكذّبهم الله.
وجاء في كتاب “تحفة الحبيب على شرح الخطيب” للبجيرمي نقلاً عن القزويني بأنّ سبب الزلزلة بعوضة خلقها الله وسلّطها على الثور الذي عليه الأرض، فهي تطير أبداً بين عينيه، فإذا دخلت أنفه، حرّك الثور رأسه، فيتحرّك جانب من جوانب الأرض. ويضيف سبباً آخر بأنّ عروق جبل قاف المحيط بالدنيا تمتدّ في أصول بلاد الأرض، فإذا أراد الله أن يعذّب بلدة، أمر ملكاً بتحريك ذلك العرق الذي هو راسخ تحتها، فتتزلزل تلك البلدة. ويقال بأنّ سبب الزلزلة بأنّ الله تجلّى للأرض فترتجف خشية منه.
مسبّبات الزلزال عند العربتعني الزلزلة في كلام العرب تحريك الشيء، وفي القرآن: “إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا” أي تحركت حركة شديدة. وتُسمى الزلزلة الرجفة. وقد جمع الدكتور عبد الله يوسف الغنيم في كتابه “أسباب الزلازل وأحداثها في التراث العربي” أهم آراء المؤرخين والجغرافيين وعلماء العرب عن أسباب نشوء الزلازل، والتي تكاد تجمع على عدّة أسباب.
يرى إخوان الصفا بأنّ الكهوف والمغارات التي في جوف الأرض والجبال، إذا لم يكن لها منافذ تخرج المياه منها وبقيت تلك المياه محبوسة، فأنّها تحمى نتيجة سخونة باطن الأرض، فتتحوّل إلى بخار، وإن لم تجد مكاناً تنفذ منه، تشقّ الأرض وتخسفها ويسمع لذلك صوت قوي.
ويذهب ابن سينا إلى تعريف الزلزلة بأنّها حركة تعرض لجزء من الأرض نتيجة بخار ريحي أو ناري في باطن الأرض، ولا شيء يحرك الأرض تلك الحركة السريعة غير الريح أو مياه تسيل بقوة. وهو بذلك يستند إلى رأي ديمقريطس، ولا يبتعد ابن حيان في تحليله عن ما سبق وكذلك القزويني، واعتبر العرب بأنّ البلاد التي تكثر فيها الآبار والأقنية تخفّف من احتباس الريح والماء مما يحدّ من الزلازل. وتعود آراء العلماء العرب إلى آراء أرسطو في كتابه “الآثار العلوية”.
هل عرف العرب ظاهرة التسونامي والهزات الارتدادية؟ربط العلماء العرب القدامى بين الزلازل وانحسار البحر، ففي عام 460 هـ انحسر البحر عن ساحل الشام مسافة يوم، فنزل الناس يلتقطون ثمار البحر، وما كشف عن سفن غارقة، فرجع البحر عليهم وأغرق خلقاً كثيراً. وفي عكا عام 702 هـ رجع البحر مقدار فرسخين. وأدّى نفس الزلزال الذي حدث في عكا إلى هيجان البحر في الإسكندرية، وتهدّمت أبراجها. وقد سجل العرب في تأريخهم للزلازل الهزاتِ الارتدادية. ويذكر السيوطي عن زلزال بغداد الموافق 551 هـ/1157 م بالحرف: “وتلا ذلك ردفات متوالية أخفّ من غيرها”.
المنازل والديارلم يكتف التراث العربي بالتأريخ للزلازل ووصف ما تحدثه من دمار كبير، وموت عميم، وتعليل أسباب حدوثها، بل كان الأدب مرآة تعكس هول الكارثة. ولربما يكون الأمير أسامة بن منقذ الذي دمر الزلزال قلعته شيزر، وأفنى أهله، خيرَ من عبّر عن عمق المصاب وقسوته. يقول ابن العديم: “ووقعت الزلازل في شهر رجب في سنة 552 الهجرية، بالشام، فخربت حماة، وشيزر، وكفر طاب، وأفامية، ومعرة النعمان، وحمص، وحصن الشميمس عند سلمية، وغير ذلك من بلاد الفرنج وتهدمت أسوار هذه البلاد”.
وأمّا شيزر، فانقلبت القلعة على صاحبها وأهله، فهلكوا كلهم… وقد هلك تاج الدولة ابن منقذ وأولاده، ولم يسلم منهم إلّا الخاتون أخت شمس الملوك زوجة تاج الدولة، ونبشت من تحت الردم سالمة، وسلم أسامة إذ كان يومئذ بعيداً عن شيزر.
كتب الأمير أسامة بن منقذ ديوانه “المنازل والديار”، حنيناً للوطن والأهل والأحباب ووتخليداً لذكرهم الذي طواه الزلزال. ويقول في سبب تأليفه هذا الكتاب: “إنّي دعاني إلى جمع هذا الكتاب، ما نال بلادي وأوطاني من الخراب، فإنّ الزمان جرّ عليها ذيله، فأصبحت، كأن لم تغن بالأمس، موحشة العرصات بعد الأنس، قد دثر عمرانها، وهلك سكانها، فعادت مغانيها رسوماً، والمسرات بها حسرات وهموماً، ولقد وقفت عليها بعدما أصابها من الزلزال ما أصابها، وهي أول أرض مسّ جلدي ترابها، فما عرفت داري، ولا دور والدي وإخوتي، ولا دور أعمامي وبني عمي وأسرتي، فبهت متحيراً مستعيذاً من عظيم بلائه، وانتزاع ما خوله من نعمائه”.
يقول أسامة بن منقذ باكياً، ومتأسياً، ومعتبراً، وشاهداً على ما فعله الزلزال: “ويحَ الزّلازِلِ أفنَت مَعشَري فإذا/ذكَرتُهُم خِلتُني في القوم سَكرانا/ بَنِي أبي إن تَبيدوا أن عَدا زَمنٌ/ عليكُمُ دون هَذا الخلقِ عُدوانا/ فلن يَبيدَ جَوى قَلبي ولا كَمَدي/ عليكُمُ أو يُبيدَ الدَّهرُ ثَهلانا”.
ويقول أيضاً: “نِمنا عن الموتِ والمعادِ فأصْ/ بَحنا نَظُنُّ اليقينَ أحْلاما/فحرّكَتْنا هذي الزّلازلُ أنْ/ تيقَّظوا كَم يَنامُ من ناما”.
ويشير ابن منقذ إلى إحدى الاحترازات التي لجأ إليها الناس هرباً من الزلزال، بأن يسكنوا بيوتاً من خشب، فيقول: تعوّضوا من مشيدات المنازل بالـ/ أكواخ فهي قبور سقفها خشبُ/
كأنّها سفن قد أقبلت وهمُ/ فيها، فلا ملجأ منها ولا هربُ”.
وذكر ابن كثير في “البداية والنهاية” قول أحدهم في الزلزال الذي أصاب الحجاز، وما رافقه من تفجّر بعض البراكين: “يا كاشف الضرِّ صفحاً عن جرائمنا/ لقد أحاطت بنا يا ربُّ بأساءُ/ نشكو إليك خطوباً لا نطيق لها/حملاً ونحن بها حقاً أحقّاءُ/ زلزال تخشع الصمُّ الصلابُ لها/ وكيف يقوى على الزلزال شمّاءُ/ أقام سبعاً يرجّ الأرض فانصدعت/ عن منظر منه عينُ الشمس عشواءُ/بحرٌ من النار تجري فوقه سفنٌ/ من الهضاب لها في الأرض أرساءُ/ كأنما فوقه الأجبال طافيةٌ/ موجٌ عليه لفرطِ اليهج وعثاءُ/ ترمي لها شرراً كالقصرِ طائشةً/ كأنّها ديمةٌ تنصب هطلاءُ”.
ونختم هذا المقال ببيت يُنسب للمتنبي، مادحاً كافور الأخشيدي بعد زلزال ضرب مصر، ونعلمُ ما يضمره المتنبي من تهكّمٍ صارخ في بيته الشعري، ونحن نرى زلزال السياسة يفوق زلزال الأرض تدميراً: “ما زلزلت مصر من كيدٍ ألمَّ بها /لكنّها رقصت من عدلِكم طرباً”.

باسم سليمان's Blog
- باسم سليمان's profile
- 24 followers



