باسم سليمان's Blog, page 16
February 7, 2023
كيف اشتبك الأدب مع المرض والأوبئة في التراث العربي؟ – ضفة ثالثة – باسم سليمان
لا ريب في أنّ الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلّا المرضى؛ هذه الحكمة القديمة كثيرًا ما يتأجّل إدراكها من قبل الإنسان حتى يمرض ويتألم.
في كتاب “تجربة الألم”، لدافيد لوبروطون، يذكر اقتباسًا من رواية “موت مربيّ نحلٍ”، للكاتب، ل. غوستافسون: “الجنة لا يمكن أن تكون إلّا بعد أن يكف الألم. غير أن هذا يعني أنّنا طالما لا نعيش الألم، فإنّنا نحيا في الجنة! ونحن لسنا على علم بذلك!”.
تقول سوزان سونتاج في كتابها “المرض كاستعارة”: “إنّ المرض هو الجانب المظلم من الحياة. إنّه مواطنة مرهقة، فكل شخص ولد مواطنًا في مملكة الأصحاء، وفي الوقت نفسه يُولد مواطنًا أيضًا في مملكة المرضى”.
لا بدّ لكل شيء إذا ما تم نقصان كما يقول أبو البقاء الرندي في رثاء الأندلس. إنّ الصحة هي التمام الذي يخشى عليه من النقصان، هكذا كُتب على الإنسان زيارة أرض المرض بشكل مؤقت، أو دائم.
اشتبك الأدب مع المرض والأوبئة في تراثنا العربي، فلم يترك الأدب المرض والوباء على مظانهما السيئة، بل ذهب في تجميلهما بالتشبيهات والاستعارات وحسن الأسلوب والعرض، وكأنّ الأدب دواء يخفّف من وطأة المرض على المريض، فيغيّر من هول الوباء عبر وصفه، أو التأريخ له، إلى دلالة انقضاء المحنة وتحقّق النجاة. ويعدّ كتاب “بذل الماعون في فضل الطاعون” للعسقلاني الذي تناول فيه الطواعين التي فتكت بالأمة العربية والإسلامية من أشمل الكتب التي تناولت الأوبئة، فيذكر فيه فصلًا قد خصّه في وصف الطاعون ناقلًا مقامة الوردي: (النبا عن الوبا) التي يذكر فيها ما فعله الطاعون بالعالم القديم، لكن الوردي يرتفع في مقامته التاريخية الواصفة إلى جماليات الأدب، حيث ينمحي الخوف من الطاعون، لتحلّ محله متعة تذوق مقامة فيها كثير من الكنايات، وبعضًا من السخرية. وفي ذكره للمدن التي أصابها الطاعون في بلاد الشام، نستمتع باللعبة الأدبية التي تغيّاها الوردي في مقامته ذاهلين عن الخوف من الطاعون: “… ثم أمزَّ المزّة، وبرز إلى برزة. وركّب تركيب مزج في بعلبك… وأزبد على الزبداني نعشه. ورمى حمص بخلل، وصرفها مع علمه أنّ فيها ثلاث علل. ثم طلّق الكنّة في حماة، فبردت أطراف عاصيها من حِماه:
أيّها الطاعون إنّ حماة من/ خير البلاد ومن أعزّ حصونها
لا كنت حين شممتها فسممتها/ ولثمت فمها آخذًا بقرونها.
ثم دخل معرّة النعمان، فقال لها: أنت مني في أمان. حماة تكفي في تعذيبك، فلا حاجة لي بك:
رأى المعرة عينًا زانها حور/ لكن حاجبها بالجور مقرون
ماذا الذي يصنعُ الطاعون في بلد/ في كل يوم له بالظلم طاعون.
لقد رأى في الطاعون قدرًا من أقدار السماء، وعدّ من مات فيه شهيدًا. وقد قيل في فوائد الطاعون بأنّه يقصّر الآمال، ويحسّن الأعمال. ويحث على اليقظة من الغفلة، والتزوّد للرحلة. وممّا قاله ابن الوردي شعرًا في ذلك:
فهذا يوصِّي بأولادِهِ/ وهذا يودِّعُ جيرانَهُ
وهذا يهيِّئُ أشغالَهُ/ وهذا يُجهِّزُ أكفانَهُ
وهذا يصالحُ أعداءَهُ/ وهذا يلاطف إخوانَهُ
وهذا يوسِّعُ إنفاقَهُ/ وهذا يخالِلُ مَنْ خانَهُ
وهذا يحبِّسُ أملاكَهُ/ وهذا يحرِّرُ غِلْمانَهُ
وهذا يُغيِّرُ أخلاقَهُ/ وهذا يعيِّر ميزانَهُ
ألا إنَّ هذا الوبا قَدْ سَبا/ وَقَدْ كانَ يرسلُ طوفانَهُ
فلا عاصمَ اليومَ من أمره/ سوى رحمةِ اللهِ سبحانَهُ.
لم يعفُ الطاعون عن ابن الوردي، فقال مسلمًا أمره لله قبل يومين من وفاته بالمرض:
ولستُ أخافُ طاعوناً كغيري/ فما هوَ غيرُ إحدى الحسنيينِ
فإنْ متُّ استرحتُ من الأعادي/ وإنْ عشتُ اشتفتْ أذني وعيني.
ننتقل بعد الطاعون إلى الأمراض الفردية، وكيف تقبّلها الشعراء، فعلى الرغم من الحمى والألم إلا أنّ الشاعر ظلّ وفيًّا للشعر، ولم تختف مفاعيله بين أنّات الألم وسعير الحمى. لكن قبل ذلك لننظر إلى رؤية الشاعر إلى الصحة، في مقابل ما يعد زينة الدنيا من مال وبنين. يقول بشار بن برد التي تذكر إحدى القصص عنه، بأنّ الجدري قد أفقده البصر:
إِنّي وَإِن كانَ جَمعُ المالِ يُعجِبُني/ ما يَعدُلُ المالُ عِندي صَحَّةَ الجَسَدِ
المالُ زَينٌ وَفي الأَولادِ مَكرُمَةٌ/ وَالسُقمُ يُنسيكَ ذِكرَ المالِ وَالوَلَدِ.
لقد ذكر كثيرًا من الأمراض في الشعر، وكان للحمى النصيب الأكبر، وذلك لأنّها ترافق كثيرًا من الآفات المرضية. وتعد قصيدة المتنبي في الحمى من أجمل القصائد التي قيلت في المرض، وخاصة أنّ المحموم هو القائل:
أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي/ وأسمعت كلماتي من به صمم.
إنّ جمال شعر المتنبي يجلو نظر الأعمى، فيعود بصيرًا، ويفتح أذني الأصم، فيصبح سامعًا، لكن الشعر الذي أبرأ به المتنبي الأعمى والأصم كان بلا حول ولا قوة أمام الحمى. ومع ذلك، كعادة الشاعر في امتطاء الخيال، أكان من خيل، أو قلق، فلا تمتنع عنه صهوة الحمى، فقد شبّه الحمى بأنثى عاشقة خجولة حتى جعل كل من قرأ القصيدة راغبًا أن تصيبه الحمى:
وَزائِرَتي كَأَنَّ بِها حَياءً/ فَلَيسَ تَزورُ إِلّا في الظَلامِ
بَذَلتُ لَها المَطارِفَ وَالحَشايا/ فَعافَتها وَباتَت في عِظامي
يَضيقُ الجِلدُ عَن نَفسي وَعَنها/ فَتوسِعُهُ بِأَنواعِ السِقامِ
إِذا ما فارَقَتني غَسَّلَتني/ كَأَنّا عاكِفانِ عَلى حَرامِ
كَأَنَّ الصُبحَ يَطرُدُها فَتَجري/ مَدامِعُها بِأَربَعَةٍ سِجامِ
أُراقِبُ وَقتَها مِن غَيرِ شَوقٍ/ مُراقَبَةَ المَشوقِ المُستَهامِ.
لقد كانت حمى المتنبي ذات حياء وخجل، لا تأتيه إلّا في ظلمة الليل، أمّا حمى الكاتب عماد الدين الأصبهاني فهي من الجرأة والثبات بمكان لكي تأتي نهارًا، لكن للشاعر من التحمّل والصبر ما يجعله يقابلها بعشق يضطرم في داخله، فتفلّ حرارة كبده حرارة الحمى:
وزائرةٍ وليس بها حياءٌ/ وليس تزورُ إلا في النهارِ
أَتتْ والقلبُ في وهجِ اشتياقٍ/ لتظهرَ ما أُواري من أُواري
ولو عرفتْ لظَى سطواتِ عزمي/ لكانتْ من سُطاي على حذارِ
تقيمُ فحينَ تُبصرُ مِن أَناتي/ ثباتَ الْطَودِ تسرعُ في الفرارِ
تُفارقني على غيرِ اغتسال/ فلم أَحلُلْ لزورتها إزاري.
لقد أظلم مرض الجدري عيني بشار بن برد، لكن مع ابن الرومي أصبح الجدري مطلبًا جماليًّا، فلا نستغرب ذلك. بودلير كان مفتونًا بآثار الجدري على وجه حبيبته، كما تذكر غريتِشن أي هنْدِرْسن في كتابها “التاريخ الثقافي للقباحة”. يقول ابن الرومي:
عبثت به الحمى فوَرَّد جسمَهُ/ وَعَكُ الحمى وتلهُّب المحـرورِ
وبدا بـه الجـدري فهو كلـؤلـؤٍ/ فـوق العـقيق مـنضَّد مسطور
ونضاه بَنْثره فجاء كعصفرٍ/ قد رُشَّ رشًا في بياض حرير
الآن صرت البدر إذ حاكى لنا/ كلفَ البدور مواضعُ التجديرِ
فكخمرةٍ رُشَّـت على تـفـاحة/ أثـرٌ يلـوح بـخـدك المـجـدور.
كان للشعراء مواقف يختلط فيها الجدّ والهزل مع الأمراض، فها هو الصاحب بن عباد يمازح صديقه أبا العلاء السعدي بعد أن أصابه الجرب:
أبا العلاء مليك الهزل والجد/ كيف النجوم التي تطلعن في الجلد.
أمّا الفرزدق، كعادته في الهجاء، فقد عدَّ غيره من الشعراء كمرض الجرب الذي كان يعالج بالقطران في ذلك الزمان:
أنا القطران والشعراء جربى/ وفي القطران للجربى شفاء.
ذهب الخوارزمي في شكوى ما آلت إليه أموره كالضرس المنخور، فقال:
وما أصبحت إلا مثل ضرسٍ/ تأكَّل فهو موجودٌ فقيدُ
ففي تركي له داءٌ دويٌّ/ وفي قلعي له ألمٌ شديدُ.
لم يكن مرض النقرس بعيدًا عن تناوله شعريّا، فقد جاء في كتاب “شفاء الغليل في كلام العرب من الدخيل”، لشهاب الدين الخفاجي المصري، مفارقة جميلة، فمن المعروف عن النقرس أنّه داء الملوك، لكن أن يصيب الفقير المحتاج، فتلك هي الفكاهة السوداء. قال المبرد: كان الحرمازي في ناحية عمرو بن مسعدة، وكان يجري عليه، فخرج عمرو بن مسعدة إلى الشام، وتخلف الحرمازي في بغداد، فأصابه النقرس، فقال:
أقام بأرض الشّام فاختل جانبي/ ومطلبه بالشام غير قريب
ولا سيّما من مفلس حلف نقرس/ أمّا نقرس في مفلس بعجيب.
وقال آخر مكنّيًا عن ما آل إليه حاله من الغنى والقلق من الافتقار:
فصرت بعد الفقر والتّهوس/ يخشى عليّ الحيّ داء النقرس.
ولقد أشار إلى ذلك الثعالبي في تحسين القبيح وتقبيح الحسن، بأنّه من محاسن الفقر أن لا يخاف عليه، كما يخشى على الغنى من الزوال. وفي ذات المعنى ذهب الصولي في كتاب العيادة، بأنّ البيت الشعري المذكور آنفًا كناية عن الغنى.
لم يتوقّف الشعراء العرب عند المرض بحدّه المفسِد للصحة، بل ذهبوا فيه مذاهب شتى كعادتهم، حتى أصبح مطلبًا جماليًّا. يذكر السّراج في كتابه “مصارع العشاق” بأنّ أشهر بيت لجرير في العشق كان على الشكل التالي:
إنّ العيون التي في طرفها مرضٌ/ قتلننا ثمُّ لم يُحيين قتلانا.
بالطبع، لم يقصد جرير المرض بالمعنى الطبي، بل إنّ صفة العيون الحوراء الناعسة الفاترة التي تفتك بالعشاق تسمح بتشبيهها بالعين المريضة لضعفها، لكن هي في المقابل كالمرض، وتأثيرها كبير. أمّا أبو نواس كعادته في الخروج عن مذاهب الشعراء، فقد رأى أن الصحة هي ما يدعو للعجب، وليس السقم الذي يصيب العاشق:
تَعجَبينَ مِن سَقَمي/ صِحَّتي هِيَ العَجَبُ.
ونختم هذا المقال مع بيت المتنبي الذي تحدّى فيه صحة ذائقة القرّاء والمفسّرين، فكل مرض مهما جمّله الشعر يُتمنّى الشفاء منه:
أَلَمٌ أَلَمَّ أَلَمْ أُلِمَّ بِدَائِهِ/ إِنْ آنَ آنٌ آنَ آنُ أَوَانِهِ.

January 31, 2023
فيلم باردو، إيناريتو ضد إيناريتو! – جريدة الصباح – باسم سليمان
مقالي في جريدة الصباح العراقية العدد 5602 تاريخ 2023 كانون ثاني
يعود المخرج أليخاندرو غونزاليز إيناريتو إلى المكسيك بعد غياب دام أكثر من عشرين عامًا، من خلال فيلم Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths)/ باردو، وقائع زائفة لحفنة من الحقائق). نال إيناريتو إثناء فترة غيابه عن المكسيك، جائزتي أوسكار عن فيلميه: Birdmanالعام 2014 و The Revenant العام 2015، فهل حان الوقت لتقديم سيرة ذاتية فيلمية، يناقش فيها؛ الوطن والهجرة، والعلاقة المحتدمة تاريخيًا بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، والأسرة والهوية، والحب والموت من خلاله شخصيًا؟ يعرض الفيلم قصة الصحفي المكسيكي ومخرج الأفلام الوثائثية سيلفيريو جاما- دانييل خيمينس كاتشو- الذي يرجع إلى المكسيك كي يكرّم عن فيلم، له ذات عنوان فيلم إيناريتو! لم يخاتل إيناريتو كثيرًا، فالشبه بين شخصيته الحقيقية، وشخصية سيلفيريو المتخيلّة شبه محسومٍ. كان إيناريتو عبر أفلامه، يستند دومًا على ثنائيات تضادية يجلو بها زيف انعدام ائتلافها عبر الخيال. فالخيال لدى إيناريتو يعتبر كحاسة، لا تختلف عن النظر واللمس، فعبره يتم اكتشاف علاقات الواقع الذي لا يمكن الإحاطة بها من دون الخيال. Bardo:
تعني كلمة باردو بالبوذية التيبتية، الحالة البرزخية التي يعيشها الإنسان في الغيبوبة التي تسبق موته. هذه الإزدواجية التي تعنيها كلمة باردو تقدّم انعكاسًا لحياة سيلفيريو/إيناريتو. فهو من جهة مواطن أمريكي يجادل بعنف موظف المطار عن أحقيته بأن يقول عن أمريكا، أنّها وطنه، رغم المفارقة بأنّ الموظف، هوالآخر، ليس من أصول أمريكية. ومن جهة أخرى يدخل مع ابنه في نقاش حادٍ، لأن الابن قد سئم من ازدواجية أبيه، فمن ناحية يدافع سيلفيريو عن المكسيك، ويطلب من ابنه أن يتكلّم المكسيكية مادام في بلده الأم. ومن ناحية ثانية لا يرى المكسيك بلدًا صالحًا للحياة!
إنّ التناقضات التي يحياها سيلفيريو تتبدّى من أول مشهد في الفيلم، حيث نرى ظل رجل يجري في صحراء، ليكتسب العزم كي يطير. وما إن يحلق الظل عن الأرض حتى يعاود الهبوط. ليتبعه مشهد ولادة ابنه ماتيو الذي همس للطبيب بعد خروجه من بطن أمه بأن يعيده إليه، فالعالم الذي جاء إليه قاس جدًا.
كان سيلفيريو متّهمًا من قبل المجتمع بخيانة مكسيكيته لصالح أمريكا، وهنا يأتي السؤال: من يحدّد الانتماء؟ الذي تأتي إجابته عبر نقاش بين سيلفيريو وهيرنان كورتيس القائد الإسباني الذي قوض مملكة الأزتيك عام 1521 ولولاه لم تكن هناك من مكسيك. كان كورتيس يجلس على هرم من الأجساد البشرية، وهناك أخبره سيلفيريو، أنّه قائد وحشي، وأنّه مكروه في إسبانيا والمكسيك، فيرد عليه كورتيس، بأنّه لو لم يكن موجودًا لم يكن هناك من مكسيك. وبالتالي ليس من سيلفيرو، ولا قضية الانتماء الشائكة التي يقع تحت تبعاتها.
ما بين الواقع والخيال على جسر من الرموز تمضي سردية إيناريتو السينمائية، لنكتشف بأنّ سيلفيريو كان قد أصيب بجلطة دماغية، تركته فاقدًا للوعي، وهو عائد في الميترو يحمل كيسًا فيه أسماك السلمندر لابنه تعويضًا له عن تلك الأسماك التي ماتت في حقيبته، عندما هاجروا إلى أمريكا. حيث تأتي دلالة سمك السلمندر من قدرته على تجديد أعضائه إن قطعت. إيناريتو أم سيلفيريو؟:
لقد ارتدى إيناريتو قناع سيلفيريو حتى لايقدّم حياته بشكل واقعي مبتذل؟ والاعتراف بأنّ محاولته جلب سمك السلمندر باءت بالفشل، فلا إمكانية لإعادة إنماء ووصل ما قطع من حياته، وما ترتب عليه من تناقضات لا حلّ لها، لكن من الممكن فهمها. هذه المفارقات المتضادة، التي تقوم عليها أكثر مشهديات الفيلم، نستطيع أن نستوعب أحد جوانبها كهجوم مضاد من قبل إيناريتو تجاه النقّاد والمشاهدين، سواء في بلد المهجر/ أمريكا، أو في بلده الأم/ المكسيك، فهناك من سيصنفه مبدعًا أو مدعيّا. وهناك من سيصنفه مرائيا، أو مرآة للواقع، وهو يريد أن يقول، بأنّه لا هذا، ولا ذاك، فالفنّ ليس كالسياسة والدين حتى يكون تأثيره شموليّا بإيجابياته وسلبياته، فما بين أنا الفنان وإنتاجه، وضمنًا حياته الشخصية، هناك الكثير من الحدود يجب أن تُقطع بشكل قانوني، أوغير قانوني، كأن يأتي اتصالٌ يخبر جماعة المهاجرين، بأنّ مريم العذراء، قد ظهرت لمن سبقهم، وهي تبارك مسيرهم نحو الحدود!
بين الباردو والسيرة الذاتية لإيناريتو علاقة زائفة، فهو لا يقدّم بالمعنى الحقيقي سيرة ذاتية والتي عادة ما تكتب على حواف نهايات العمر، بل يريد القول، بأنّ السير الذاتية تتعدّد، حتى من قبل صاحبها، كما التاريخ حسب من يكتبه، والحدود وفق من يضعها، والانتماء على هوى القناعة، والهوية ليست إلا قضية إدارية، والوطن مجرد جذر مخاتل، والمهجر هروب مفضوح، فلا شيء نهائي في تلك القيم، فالحقائق زائفة بقدر ما تدعي واقعيتها.
فيلم: باردو، وقائع زائفة لحفنة من الحقائق 2022، من إخراج أليخاندرو غونزاليز إيناريتو، وتصوير داريوس خوندجي، وسيناريو إيناريتو و نيكولاس جياكوبون.
باسم سليمان
خاص الصباح

عندما كتبتْ لعبة الشطرنج التاريخ – ضفة ثالثة – باسم سليمان
لا يناقض اللعِبُ الإنساني الجدّ في جوهره، فلقد ذكر هيدغر في كتابه “مبدأ السبب” أنّ الترجمة الأصحّ لمقولة ليبنتز: “وجِد العالم بينما كان الإله يحسب” هي: “وجِد العالم بينما كان الإله يلعب”؛ لكن، ما هذا اللعب؟ قال أفلاطون في كتابه “القوانين”: “إنّنا دمى الإله، ويجب أن نلعب حياتنا بطريقة جيدة”. إنّ نظرة أفلاطون تقوم على أنّ عالم البشر هو لعبة، إنْ أحسنت قيادتها، نجت روحك، وإنْ لم تحسن، خسرت روحك. هذه الرؤية تجد صداها في ما قاله يوهان هوتسينغا(1): إنّ اللعب قديم قدم البشرية، فاللعب كان في منشأ الحضارة. فالحضارة تتطلّب الاجتماع الإنساني، اجتماع أولئك الذين يستطيعون اللعب، ويفهمون كيف يكون اللعب. مهما يكن، فاللعب لم يكن أبدًا مجرد تزجية للوقت في تاريخ الإنسان، وإن تم تسليعه في أزمنتنا الحديثة، إلّا أنّه كان حمّال أوجه ومعان وغايات منذ لحظة اختراعه.
ما بين الحساب واللعب قصة جميلة وحكمة خفيّة أوردها ابن خلكان في كتابه “وفيات الأعيان”، وذلك أنّ الحكيم صصه بن داهر كان قد عرض لعبة الشطرنج على الملك شِهرام الهندي، فأعجب الملك بالشطرنج جدًا، ورأى فيه آلة للحرب، وعزًّا للدين والدنيا، وأساس كل عدل، فأراد أن يكافئ الحكيم صصه، فما كان من الحكيم إلّا أنْ طلب أن يوضع في البيت الأول من رقعة الشطرنج حبة قمح واحدة، وفي الثانية اثنتين، وفي الثالثة أربع، وفي الرابعة ثماني حبات، وهكذا حتى تنتهي بيوت رقعة الشطرنج التي عددها أربعة وستون بيتًا. استهجن الملك هذا الطلب، لكنّ الحكيم أصرّ عليه، فأمر الملك خزنتَه أن يمتثلوا لرغبة الحكيم. وبعد فترة عادوا إليه وأخبروه بأنّ مخازن الملك لا تكفي، بل قمح الدنيا كلّها لا يكفي. دُهش الملك من السرّ الخفي في هذه اللعبة، فازداد إعجابًا بها. وقد أورد المسعودي بأنّ الهنود يتغيّون من هذا التضعيف الارتقاء نحو العلّة الأولى التي تعلو على الأفلاك. ذكر ابن خلكان أنّه كان في شكّ من ذلك الحساب، حتى استنجد ببعض أصحاب الحساب في الإسكندرية، فأثبتوا له ذلك. هذه الحسبة تُسمى المتوالية الهندسية، والناتج عنها كما جاء في كتاب “الرياضيات المسلّية” لياكوف بيريلمان بأنّه يُحتاج لمخزن مملوء بالقمح ارتفاعه أربعة أمتار، وعرضه عشرة أمتار، ويمتدّ لمسافة 30 مليون كم، أي أكبر من المسافة من الأرض إلى الشمس بمرتين.
الشطرنج من أقدم الألعاب التي عرفتها البشرية. نسجت القصص التي تسبّبت في اختراعه، بما يشابه أسلوب لعبه القائم على تدبّر الحركات وبعد النظر، وفهم الغايات. يذكر هيرودوت، المؤرخ الإغريقي، بأنّ الشطرنج وجِد من أجل تسلية الجنود الإغريق في حصارهم لأسوار طروادة. لكن لنتأمّل هذه التسلية، التي كانت سببًا في إيجاد حصان طروادة الذي صُنع بتوجيه من القائد أوديسيوس، وبه فُتح باب المدينة المنيع. أليس الحصان هو قطعة الشطرنج الوحيدة التي تستطيع القفز فوق رؤوس قطع الخصم، لتستقرّ خلف خطوطه الدفاعية!
جاء في “الشاهنامه”(2) بأنّ الملك الهندي جَمهور قد مات بعد أن أنجب ابنًا اسمه (كو) من زوجته التي تزوجت بعد وفاته بأخيه، وأنجبت منه ابنًا اسمه طلخند. شبّ الأخوان وعين كل منهما على العرش، فاختصما وتقاتلا، وعلى الرغم من أنّ كو كان ميّالًا للسلام على العكس من أخيه، لكن في النهاية انجلت المعركة عن انتصار كو على طلخند الذي مات كمدًا، بعدما وجد نفسه وحيدًا من دون ماله وجنده. فُجعت الملكة بما آلت إليه الأمور، فهي أمّ للقتيل والقاتل، فهذا هو المصاب الأكبر الذي لم تكن تتوقّعه أبدًا. لم يكن أمام كو إلّا أنْ يشرح لأمّه أنّه لم يقتل أخاه، بل إنّ أخاه مات حتف أنفه إثر خسارته لقادته وجنده، فما كان من كو إلّا أن مثّل لها ذلك برقعة عليها قطع جيشين متحاربين تعاركا حتى خسر أحد الملكين كل قطعه، وبقي وحيدًا أعزلَ، وبذلك تكون الحرب/ اللعبة قد انتهت عن انتصار الملك الذي لم يزل يملك بقية من القطع. وأمام هذه التمثيلية الحربية، فهمت الأم بأنّ ابنها كو لم يقتل ابنها الآخر طلخند(3).
كتب أبو القاسم الفردوسي “الشاهنامه” للسلطان محمود الغزنوي، الذي حكم بين 998 و1030 ميلادية، وسرد فيها تاريخ الفرس. وعلى ما يبدو أنّ ذكره لقصة اختراع الشطرنج كانت لمقصد يُعرف من حياة السلطان الغزنوي الذي تصارع مع أخيه الأصغر إسماعيل، الذي أعلن نفسه حاكمًا بعد موت أبيهما، لكنّ محمود لم يرض بذلك، وعرض على أخيه أن يتولّى حكم خراسان وبلخ، شرط أن يتنازل عن العرش، فرفض إسماعيل، فدارت رحى الحرب بينهما، وانتصر محمود وهرب أخوه إلى أحد قلاعه، فحوصر وقتل. إذًا، نحن هنا أمام حادثة تاريخية خُرّجت قصصيّا على يد الفردوسي، قاصدًا منها تقديم العزاء والسلوان، والأهم التبرير العقلي لسلطانه الجديد، لِما فعله بأخيه.
الإسقاط التاريخي الذي عُبِر عنه بقصة اختراع الشطرنج على يد الفردوسي نجد شبيهًا له في الصراع بين الأمين والمأمون، حيث يُذكر بأنّ الأمين(4) كان مولعًا بالشطرنج. وعندما حوصر من قبل جيوش أخيه، دخل عليه الرسول الهلع من خطورة الموقف، فوجده يلعب الشطرنج، فقال له: “يا أمير المؤمنين أتوسّل إليك أن تسرع، ليس هذا وقت اللعب”، فأجابه الأمين: “صبرًا صبرًا، فإنّني أتوقّع الفوز بعد بضع نقلات”! يبدو موقف الأمين غريبًا، فهل أذهلته انتصارات أخيه عن الواقع، وشطح به الخيال، بأنّ انتصاره على رقعة الشطرنج، سيكون بديلًا عن الانتصار في الواقع؟ يحكي الأبشيهي بأنّ ملوك الهند لم يكونوا يميلون إلى القتال، لذلك اخترعوا الشطرنج، فإن تخاصم ملكان على شيء ما، لعبا بالشطرنج والمنتصر يأخذ الشيء المتنازع عليه، أكان أرضًا أو مملكة، فهل كان الأمين يمنّي النفس بعادات ملوك الهند؟ لقد أودى ولع الأمين بالشطرنج بملكه وحياته، على عكس المأمون الذي كان هو الآخر مفتونًا بالشطرنج، لكنّه لم يكن بالمهارة التي تنسيه الواقع، فقد ذكر القلقشندي بأنّ المأمون لم يكن يجيد اللعب بالشطرنج، فقال غاضبًا(5): “أنا أدير الدنيا، فأتسع لذلك، وأضيق عن تدبير شبرين في شبرين”، يقصد رقعة الشطرنج.
العرب والشطرنج:
عرف العرب الشطرنج عن طريق الفرس، فأصّلوا نشأته عبر مخيال تأريخي تُسبّب به أسباب العمران. فقد ذكر المسعودي(6) بأنّ الشطرنج قد اخترع على زمن الملك بلهيت في الهند، لإظهار أنّ الظفر يناله الحازم، والبلية تلحق بالجاهل، فكان الشطرنج سببًا في تراجع لعبة النرد التي اخترعها الفرس على زمن أزدشير بن بابك، والتي كانت تقوم على الحظ والقدر، في حين يعتمد الشطرنج على التدبير والفكر وحرية الإرادة. هذا التعارض بين اللعبتين وجد له صدى في دنيا التفكير العربي، بين من يقولون بالإرادة الحرّة، ومن يقولون بالجبر. وقد أشار المسعودي في “مروج الذهب” إلى ذلك بقوله: “وذكر بعض من أهل النظر من الإسلاميين أنّ واضع الشطرنج كان عدليًا مستطيعًا في ما يفعل، وأنّ واضع النرد كان مجبرًا، فتبين باللعب بها أنّه لا صنع له فيها، بل تصرفه فيها على ما يوجبه القدر عليه فيها”. وأورد في ذلك أشعارًا لأبي نواس عن لعبة النرد تبيّن مذهب الجبر فيها:
ومأمورة بالأمر تأتي بغيره/ ولم تتبع في ذلك غَيًّا ولا رشدا
إذا قلتُ لم تفعل وليست مطيعة/ وأفعل ما قالت فصرت لها عبدا.
جاء في رسائل عبد الحميد الكاتب بأنّ الخليفة الأموي الأخير مروان بن محمد أمر بمنع الشطرنج. لم يأت هذا القرار بالمنع كالأحكام القراقوشية، بل انطلق من قناعة الخليفة بأنّ معارضيه كان أكثرهم يلعبون الشطرنج. وبالتالي كانوا يعارضون الفقه السياسي الجبري الذي يرى بالحاكم قدرًا إلهيّا لا يجوز الخروج عليه. وقد أشار إلى ذلك محقِّق رسائل عبد الحميد الكاتب، الدكتور إحسان عباس، بأنّ أكثر المنكبين على لعب الشطرنج في زمن مروان بن محمد كانوا من المعارضين للحكم الأموي!
لقد استند مروان بن محمد في منعه للشطرنج إلى فتوى للفقيه مالك بن أنس، والتي لا يفهم منها التحريم القطعي، بل الكراهة، لأنّ قطع الشطرنج كانت عبارة عن تماثيل مجسّمة، إضافة إلى أنّ لعب الشطرنج كان يترافق أحيانًا بالمراهنة وتسفيه المغلوب. لقد ذهب قرار المنع قبض الريح، فقد انتشر الشطرنج في العالم العربي والإسلامي. ومن كثرة شغف العرب بالشطرنج، نسبوا اختراعه إلى أبي بكر الصولي، لاعب الشطرنج الكبير.
على هذه الأرضية من القصص والأخبار ازدهر ولع العرب بالشطرنج، فتخلّل حياتهم السياسية والدينية والأدبية. وممّا يشير إلى تجذره في حياتهم الاجتماعية، ما ذكره عبد الحميد الكاتب في رسالته، بأنّ الشطرنج قد شغل البعض عن القيام بواجباتهم الأسرية والدينية، فقد كانوا يتلاعبون به من الصباح إلى المساء. هذا الشغف كان لا بدّ أن يتسلل إلى الشعر والقصص ويصبح مدارًا للتفكّه والأمثال.
متى فرزنت(7) يا بيدق؟
هذا المثل ذكره الميداني في كتابه “مجمع الأمثال”، فيما أحدثه المولّدون من أمثال، حيث كانت العرب لا تتمثّل إلا بما جاءها من أمثال قبل أن تختلط بالأمم الأخرى بعد الفتوح الإسلامية، لكنّ غنى لعبة الشطرنج فرض ثقافتها على العرب. ومن قواعدها أنّ البيدق/ الجندي، وهو أضعف قطعة في الشطرنج، إذا وصل إلى الجانب الآخر من اللوحة يترقّى ويصبح فرزانًا/ وزيرًا، أو أية قطعة أخرى يرغب بها اللّاعب. ويضرب هذا المثل في الصغير الذي يتكبّر! وذكر الثعالبي مثلًا آخر في كتابه؛ خاص الخاص: زاد في الشطرنج بغلة. ويضرب لمن أتى عملًا أحمقَ. وعلى المنوال نفسه نسج ابن شرف القيرواني:
يَقولونَ سادَ الأَرذَلونَ بِعَصرِنا/ وَصارَ لَهُم قَدرٌ وَخَيلٌ سَوابِقُ
فَقُلتُ لَهُم وَلّى الزَمانُ وَلَم تَزَل/ تُفَرزِنُ في أُخرى البُيوتِ البَيادِقُ.
هذ المثل، وإن كان ظاهره التحقير، لكن له دلالة مغمضة جميلة، وهي أنّ الصغير الحقير ينال المجد والمعالي، إنّ أحسن السعي. وفي ذلك يقول ابن قلاقس:
والصغير الحقير يسمو به السّ/ير فيعنو له الكبير الجليل
فرزن البيدق التنقل حتى انـ/ ـحط عنه في قيمة الدست(8) فيل.
أصبحت هذه الصورة الشعرية للبيدق المتفرزن كالقطعة النقدية يتداولها الشعراء وفق مآربهم. يقول صفي الدين الحلّي من العصر المملوكي متفاخرًا:
سَلي الرِماحَ العَوالي عَن مَعالينا/ وَاِستَشهِدي البيضَ هَل خابَ الرَجا فينا
بَيادِقٌ ظَفِرَت أَيدي الرِخاخِ (9)بِها/ وَلَو تَرَكناهُمُ صادوا فَرازينا.
تغيب النساء عن قطع الشطرنج، فالفرزان الذي نعرفه في زمننا بالوزير تحوّل في أوروبا إلى الملكة(10)، وفيه إشارة إلى السيدة العذراء، لكن “ألف ليلة وليلة” اقتصّت من هذا الإغفال. ففي قصة الجارية تودّد، تحكي شهرزاد كيف أنّ تودّد قد انتصرت على العلماء والفقهاء، ولذلك يطلب منها الرشيد أن تلاعب أحسن لاعبيه في الشطرنج، فتذيق شاه هذا اللاعب طعم (الكش مات) مرّات عديدة، تومئ بها إلى هذا الإغفال، وتنتقم منه تخييليًّا. لقد ذكر كثير من الشعراء ملاعبة عشيقاتهم بالشطرنج، حتى أنّ الرشيد كان يلاعب زوجته زبيدة، لكنّ كل ذلك لم يدفع العرب إلى إدخال المرأة في عداد قطع الشطرنج، مع أنّهم عرفوا العديد من أنواع رقع الشطرنج وقطعها، فمنهم من زاد عليها أبياتًا، ومنهم من جعلها مماثلة للجوارح الإنسانية.
شاه مات أم شامات…
بين الحبّ والحرب حرف الراء، وهي راء مستعارة من كلمة الشطرنج! إنّ مصطلح الشاه مات دلالة على انتصار أحد لاعبي الشطرنج، أمّا الشامات، فهي حسن قتّال في الوجه. يقول أبو نواس:
تلاعبت بالشطرنج مع من أحبّه/ فنادمني حتى سكرت من الوجد
وأنشدني مالي أراك مفكرًا تدور/ على الشامات وهي على خدي.
لقد دخل الشطرنج ساحة القلوب، ولربما كان مبتدؤه مع قصيدة تُنسب لامرئ القيس، فيها كثير من المعاني الإيروتكية المضمرة:
ولاعَبتُها الشِّطرَنج خَيلى تَرَادَفَت/ ورُخّى عَليها دارَ بِالشاهِ بالعَجَل.
إلى أن يقول:
وقَد كانَ لَعبي كُلَّ دَستٍ بِقُبلَةٍ
أُقَبِّلُ ثَغرًا كَالهِلَالِ إِذَا أَفَل.
ومن الأشعار الجميلة التي وصفت لعبة الحب الشطرنجية ما قاله صفي الدين الحلي، فقد جمعت الأيام بينه وبين من يحب، وقد اعتقد أنّه لا لقاء:
وَغَـزالٍ غـازَلـتُـهُ بَعدَ بَينِ/ َلَّـفَـتْ بَـيـنَهُ المُدامُ وَبَيني
صالَحَتني الأَيّامُ بِالقُربِ مِنهُ/ بَعدَما كُنتُ مِنهُ صِفرَ اليَدَينِ.
وبعد أن حدث اللقاء، كان لا بدّ من منازلة الحبيب شطرنجيًّا، فيكمل الحلّي وصف المعركة التي دارت بينه وبين الحبيب. وقد رأى ويل ديورانت هذه القصيدة أول وصفٍ للعبة شطرنجية كاملة. هنا، نذكر أبياتها التي دفعت ويل ديورانت لهذا القول:
فَـصَـفَفنا الجَيشَينِ تُركًا وَزَنجًا/ وَاِعـتَـبَـرنا تَقابُلَ العَسكَرَينِ
فَـاِبـتَـدانـي بِدَفعِهِ بَيدَقَ الفِر/زانِ مِـن حِـرصِهِ عَلى نَقلَتَينِ
وَأَدارَ الفِرزانَ في بَيتِ صَدرِ ال/شـاهِ نَـقـلًا يَـظُنُّهُ غَيرَ شَينِ
فَـعَقَدتُ الفِرزانَ مَعَ بَيدَقِ الصَد/رِ وَسُـقتُ الفيلَينِ في الطَرَفَينِ
فَـتَـدانـى بِالرُخِّ بيتًا وَأَجرى/ خَـيـلَـهُ بَـينَ مُلتَقى الصَفَيّنِ
فَـرَدَدتُ الـفِرزانَ ثُمَّ نَقَلتُ ال/فـيـلَ فـي بَيتِهِ عَلى عُقدَتَينِ
ثُـمَّ شاغَلـتُهُ وَأَرسَلتُ فيلي/ مِنجَنيقًا يَرمي عَلى القِطعَتَينِ
فَأَخَذتُ الفِرزانَ حُكمًا وَوَلّى/ رَخُّـهُ ناكِـصًا عَلى العَقِبَينِ
ثُـمَّ حَصَّنتُ مِنهُ نَفسي عَنِ الشا/هِ بِـعَـقـدِ الـفِرزانِ بِالبَيدَقَينِ
ثُـمَّ بَـرطَـلـتُـهُ بِبَيدَقِ فيلي/ وَدَفَـعـتُ الثاني عَلى الفَرَسَينِ
فَـأَخَذتُ اليُمنى وَأَجفَلَتِ اليُس/رى شَرودًا تَجولُ في الحَومَتَينِ
وَتَـقَـدَّمـتُ مِن خُيولي بِمُهرٍ/ أَدهَـمِ اللَونِ مُصمَتِ الصَفحَتَينِ
ثُـمَّ سَـلَّطتُهُ عَلى الشاهِ وَالرَ/خِ فَـعَـجَّـلـتُ أَخذَهُ بَعدَ ذَينِ
ثُـمَّ لَـقَّـطتُ مِن بَيادِقِهِ الشُر/رَدِ خَـمـسـًا عاجَلتُهُنَّ بِحَينِ
فَـاِنـثَنى يَطلُبُ الفِرارَ وَجَيشي/ راجِـعـًا نَـحوَهُ مِنَ الجانِبَينِ
ثُـمَّ ضـايَـقـتُهُ فَلَم يَبقَ لِلشا/هِ عَـلـى رُغـمِهِ سِوى بَيتَينِ
فَـمَـلَكتُ الأَطرافَ مِنهُ وَسلَّط/تُ عَـلَـيـهِ تَـطابُقَ الرَخَّينِ
ثُمَّ صِحتُ اِعتَزِل فَشاهُكَ قَد ما/تَ بِـلا مِـريَـةٍ وَقَد حَلَّ ديني.
ما هي الحياة؟
سُئل الخليفة هارون الرشيد: ما هو الشطرنج؟ فأجاب بسؤال آخر: ما هي الحياة؟
أليس جواب الرشيد الذي كان أول الخلفاء العباسيين الذي لعب الشطرنج، وأهدى الملك شارلمان شطرنجًا، مشابهًا لِما ذكر المسعودي بأنّ الملك الهندي بلهيت كان يلعب الشطرنج مع حاشيته، فجعلها مصوّرة على هيئة الناطقين، وغيرهم من كائنات ممّا ليس بناطق، فرتبهم درجات ومراتب. وجعل الشطرنج ضابطة للمملكة، وكان الهنود ينظرون فيها، فيما هو عاجل وآجل. إنّ ما ذهب إليه بلهيت ليس إلّا الحياة ممثّلًا لها بالشطرنج، فليس غريبًا بعد ذلك أن يقول الرشيد للغمامة: أمطري حيث شئت، فخراجك لي!
هذه الفلسفة التي ترى الحياة كالشطرنج لم تكن غائبة عن صراع الأمين والمأمون. وما ذكره السيوطي من أخبار نزاعهما نستطيع أن نستوعبه بعمق، إذا سردنا ما جاء من أخبار عن السلطان محمود الغزنوي(11) بأنّه عندما دخل عليه مجد الدولة البويهي، قال له السلطان الغزنوي له: “أما قرأت شاهنامه، وهي تاريخ الفرس، وتاريخ الطبري، وهو تاريخ المسلمين؟ قال: بلى! قال ما حالك حال من قرأها! أما لعبت الشطرنج؟ قال: بلى! قال: فهل رأيت شاهًا يدخل على شاه؟ قال: لا. قال: فما حملك أن تسّلم نفسك إلى من هو أقوى منكَ؟ ثم سيّره إلى خرسان مقبوضًا عليه”.
لم يكن المثل الذي شاع عند العرب في بغداد غير معلوم عند الشاعر ابن عمّار في إسبانيا، بأنّ البيادق لها الحق بأن تصبح فرازنة. نشأ ابن عمّار في عائلة مغمورة، لكنه حثّ السير وفق شعر ابن قلاقس، فأصبح وزيرًا في زمن المعتمد ابن عباد. ويحكى عنه أنه استخلص مدينة أشبيلية من الملك ألفونسو السادس بعد أن هزمه بلعبة شطرنج!
لقد كانت لعبة الشطرنج مخيالًا تأريخيًّا، استطاع العرب من خلالها مقاربة أحداث سياسية ومجتمعية ودينية، فقد رمّزوا بها عن أشياء، وصرّحوا بها عن أخرى، ولعبوا بها بين جدّ وهزل، فسقطت عروش، وقامت أخرى على رقعة من أربعة وستين بيتًا، واثنتين وثلاثين قطعة، وصرخة انتصار: شاه مات.
ونختم هذه المقالة بقول الشاعر أبو القاسم الشجري من القرن الرابع هجري، وفيه يظهر إلى أي مدى وصل الاهتمام بالشطرنج في التراث العربي:
إنْ شئت تعلمُ في الآداب منزلتي/ وأنّني قد عَدَاني العزّ والنعمُ
فالطرف والسيف والأوهاق تشهد لي/ والعود والنرد والشطرنج والقلم.
المصادر والهوامش:
1 ـ ديناميكية اللعب في الحضارات والثقافات الإنسانية، يوهان هوتسينغا. هيئة أبو ظبي للثقافة 2012.
2 ـ الشاهنامه، أبو القاسم الفردوسي. مطبعة دار الكتب المصرية 1932.
3 ـ قديمًا كان الانتصار في الشطرنج يحصل عندما يخسر أحد ملكي الرقعة كل قطعه.
4 https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%A8%D9_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%D9%D9_%D9%D8%AD%D9%D8%AF_%D8%A7%D9%D8%A3%D9%D9%8A%D9_%D8%A7%D9%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A.
5 ـ تاريخ الخلفاء، السيوطي. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، الطبعة الثانية 2013.
6 ـ مروج الذهب ومعادن الجوهر، الجزء الأول، المسعودي. دار الرجاء 1939.
7 ـ مأخوذة من الفرز، أو الفرزان، وهو الوزير، أو الملكة.
8 ـ الدّسْت: اللعبة. فلان حسن الدّست: شطرنجي ماهر. الدّست: الغلبة في الشطرنج.
9 ـ الرُّخُّ: قطعةٌ من قطع الشِّطْرَنج، وهي القلعة (الطابية).
10 ـ https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%D8%B2%D9%8A%D8%B1_(%D8%B4%D8%B7%D8%B1%D9%D8%AC).
11 ـ الكامل في التاريخ، ابن الأثير. الناشر بيت الأفكار الدولية 2009.https://diffah.alaraby.co.uk/diffah/revisions/2023/1/29/%D8%B9%D9%D8%AF%D9%D8%A7-%D9%D8%AA%D8%A8%D8%AA-%D9%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%D8%B4%D8%B7%D8%B1%D9%D8%AC-%D8%A7%D9%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE

January 22, 2023
الانعتاق ليس فيلمًا عن الظهر المحروث بالسّياط!
مقالي في جريدة الصباح العدد 5595 العام 2023 كانون الثاني
يذكر جوناثان غوتشل في كتابه؛ الحيوان الحكّاء، بأنّ إبراهام لينكولن، قد قال للكاتبة هارييت بيتشر ستو صاحبة رواية كوخ العم توم: ” إذن، أنت المرأة الصغيرة مؤلّفة الكتاب الذي أشعل الحرب الأهلية”. صدرت هذه الرواية عام 1852 وبعدها بسنوات قامت الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب. أعلن لينكولن في الواحد من كانون الثاني عام 1863 بأنّ جميع العبيد في الولايات الانفصالية؛ هم أحرار. التقط العبد جوردن هذا الصوت، وقرّر الهرب باتجاه القوات الاتحادية، لكي ينال حريته، وبعد عشرة أيام من الهرب المضني تحت وقع نباح كلاب أسياده البيض ورصاصاتهم وصل إلى أحد معسكرات الاتحاديين في باتون روج في ولاية لويزيانا. خضع جوردن للكشف الطبي، قبل أن يلتحق بالجيش الاتحادي، وعند الكشف على ملاءمته للخدمة العسكرية صُدم الأطباء بمنظر ظهره الذي يشبه أرضًا محروثة بشكل عشوائي. لقد كانت تلك الأثلام من آثار السياط التي مزقت ظهره في مزرعة سيده الأبيض في الجنوب الأمريكي، حيث كان يعمل في حقول القطن والبصل. تحوّلت هذه الصورة لأيقونة دعائية سياسية في الحرب بين الشمال والجنوب.
حاز ويل سميث جائزة الأوسكار عن دوره في فيلم الملك ريتشارد عام 2022 الذي يصوّر صراع والد لاعبتي التنس العالميتين سيرينا وفينوس ويليامز من أجل أن يؤمّن لهما الظروف المناسبة كي يصلا إلى عرش لعبة التنس. وبعد ذلك بقليل قام ويل سميث بصفع مقدم جائزة الأوسكار بعد أن تنمّر على زوجته! لكن، ما الداعي، لذكر كل ما تقدّم أعلاه في مناقشة الفيلم الجديد Emancipation/ الانعتاق؟ الذي يعرض حاليًا في صالات السينما والمنصات الرقمية، وهو من بطولة ويل سميث، والذي يستند إلى قصة حقيقية تعود إلى جوردن صاحب الظهر المحروث بالسياط، والذي انتشرت صورته إبّان الحرب الأهلية الأمريكية، وما بعدها، كرمز على فظاعة العبودية. لا يملك التاريخ إلا النزر اليسير عن سيرة المنعتِق جوردن والذي أصبح في فيلم Emancipation يُدعى بيتر بإشارة إلى القديس بطرس، والذي يلعب دوره الممثل ويل سميث تحت إدارة المخرج أنطوان فوكوا وسيناريو ويليام كولاج، حيث شارك ويل سميث كأحد المنتجين.
يعرض الفيلم حكاية بيتر الذي يفرّ من سيده فاسِل الذي لعب دوره بن فوستر، والذي كان قد تعهّد تأمين العمال السود لإنشاء سكّة حديدية تنقل على قضبانها المدافع الكبيرة التي ستكون عاملًا حاسمًا في الحرب بين الشمال والحنوب. وفي خضم هذا الجحيم يسمع بيتر بأنّ لينكولن أعلن بأنّ كل عبد هارب من الولايات الانفصالية، سينال الحرية. تلتقط أذنا بيتر كلمة الحرية، ويبدأ هروبه من المعسكر عبر مستنقع يمتد على مساحة 40 ميل أقل ما يواجهه فيه من مخاطر التماسيح وكل ذلك تحت وقع مطاردة فاسِل له مع مساعديه وكلاب مدربة لإقتفاء الأثر، إلى أن تنتهي القصة بمقتل فاسِل على يد أحد الجنود السود المحرّرِين وينجو بيتر. هذا المختصر سنجده في كل قصص الهروب التي جرت في ذلك الزمن القبيح! فما الذي يميّز قصة بيتر عن غيرها؟ كقصة فيلم اثنتي عشرة سنة من العبودية التي تُجسد قصة سولمون نورث الذي اختطف من الشمال وبيع كعبد في الجنوب، أو جانغو الحرّ، إخراج تارانتينو؟ يأتي الجواب من خلال ويل سميث الذي قال في إحدى اللقاءات معه، بأنّ القصة لا تتعلّق بالهروب، بل بأنّ بيتر أصبح حرًّا، عندما آمن يذلك؟ هذا الكلام العميق لويل سميث لا تجد له أثرًا في الفيلم على الرغم من المشاهد المؤثِّرة التي يظهر فيها بيتر يغسل قدمي زوجته قبل أن يبيعه سيده إلى فاسِل، أو في جدله مع أحد العبيد المسجونين الغاضبين من طرح بيتر عن إله رحوم، فيما الواقع يقدّم إلهًا راضيًّا بكل هذا العذاب المصبوب على أجساد العبيد. وحتى عندما سمع بيتر هاتفًا يناديه باسمه في جحيم المستنقع وكأنّه صوت الإله يضيء له ظلمات المستنقع حتى يصل إلى النور. تظلّ تلك الأحداث غريبة عن ما قصده الفيلم! فالمطاردة التي أحسن المصوِّر روبرت ريتشاردسون في إدارة زوايا التصوير فيها، تأخذك بعيدًا عن معاناة عبد هارب إلى قصة مشوّقة لمغامر يخوض معركة مع تمساح وينتصر عليه، ومن ثم يجد قاربًا يبحر عبره في المياه السوداء للمستنقع. لربما يعود ذلك إلى أنّ المخرج أنطوان أراد تقديم مطاردة هوليودية معتمدًا على سطوة تاريخ ويل سميث في الأفلام الحركية: رجال في الأسود، وأنا أسطورة، بالإضافة لشخصية الأب، سواء في الملك ريتشارد، وأنا أسطورة! وذلك من أجل إظهار قوة الإرادة في شخصية بيتر عندما أدرك معنى الحرّية، مع أنّ هذا المنحى سيؤدي إلى تمييع شخصية العبد الهارب نحو الحرية عبر تحويله إلى بطل إثارة هوليودية! لكن السؤال الذي يطرح، هل كان سميث موافقًا على هذا المقتل الإخراجي، الذي سيعيد إلى الأذهان صورته كبطل هوليودي لأفلام الحركة وإن كان سيكرّس صورة الأب والزوج المدافع عائلته؟ لربما تكون الإجابة ظنيّة، وذلك بأن تساعد سيرة نضال العبد من أجل حريّته على جبّ صورة الصفعة التي مازالت طرية العهد، وما سببت لويل سميث من مشاكل وعقوبات، حتى أنّه صرّح، بأنّه لا يعرف إذا كان المشاهدون مستعدين لرؤيته من جديد بعد تلك الصفعة! إذن ويل سميث ومخرج الفيلم كانا مدركين للربط الذي سيحصل بين شخصية بيتر وشخصه ويل سميث الحقيقي! وهنا نسأل، لقد كان بيتر هاربًا من مستعبديه نحو الحرية، أمّا ويل سميث، فهل كان يأمل من صورة جوردن أن يقال له في المستقبل: هذه هي الصورة التي أدخلت صفعتك في النسيان!
قد نكون متجنّين في هذا التحليل على الممثّل ويل سميث، وخاصة أنّ إرهاصات التحضير للفيلم قد بدأت عام 2018، قبل الصفعة المدوية على مسرح الأوسكار، لكن بمقارنة بيتر/ ويل سميث مع شخصيات أخرى في الفيلم نجدها أكثر إقناعًا في التعبير عن دورها، فبن فوستر عندما سرد قصة مقتل الخادمة السوداء على يد أبيه، تلك الخادمة التي ربّته بعد موت أمّه وعلمته الكثير، كان قادرًا على إيضاح كيف تحوّل ذلك الطفل الذي كان يرغب بأن تجالسهم الخادمة على المائدة وتشاركهم الطعام، إلى ذلك القاتل الذي لا يرحم. هذه المقارنة بين ويل سميث وغيره من الممثلين ترجح لصالح غيره، على الرغم من أنّه قد نال حصة الأسد في الفيلم، ولربما يعود السبب في هذا الاختلال، إلى أنّ ويل سميث كان يهرب من تلك الصفعة. عود على بدء، يعلّق غوتشل على كلام لينكولن، بأنّه مجرد مجاملة مصطنعة لأنّ الحروب تقدح نيرانها لأسباب أخرى، مع أنّه يضع جملة لينكولن ضمن آليات تأثير الكتب. لقد باعت رواية العم توم كثيرًا، بل إنّها وصلت للمرتبة الثانية بعد الكتاب المقدس. لقد أثّرت على الرأي العام وأصبحت أنجيل تحرّر وتضامن مع الملونين الذين ينشدون الحرية. وهنا نجد الحالة ذاتها، فصورة جوردن أصبحت أيقونة أيضًا، لكن بيتر/ ويل سميث رزح تحت ثقلها، ومن أجل تفادي تلك الصورة الأيقونية تم قذفها زمنيّا في الفيلم إلى لحظاته الأخيرة، أي إلى ما يقابل اللحظة التاريخية الفعلية عندما تم التقاط الصورة لظهر جوردن المحروث بالسياط في المعسكر بعد نجاته من مطاردة مستعبديه وكأنّ المخرج بهذه الحركة يريد أن يحرّر بيتر/ ويل سميث من الثقل الأيقوني لصورة ظهر جوردن. لقد كان سميث محقًّا عندما قال، بأنّ الفيلم ليس قصة هروب أحد العبيد، بل إدراك هذا المستعبَد لمعنى كلمة الحرية. وهنا نفهم لماذا أغفلت السياط التي ظهرت آثارها على ظهر بيتر، على عكس ممّا حدث في فيلم اثنتي عشرة سنة من العبودية، لكن اللعبة الذكية في إغفال الجلد وتأخير ظهور صورة ظهر بيتر، كي يتم التركيز على معنى كلمة إدراك كلمة الحرية من قبل العبد بيتر، لم تكن مقنعة، فما إن ظهرت الصورة في الفيلم حتى استدعيت شخصية جوردن وليس بيتر، وفي الوقت نفسه ذكرى الصفعة. هذا التخبط لم ينته، بل زيد بلّة مع إضافة الرقم 40 الذي يشير إلى مساحة المستنفع وما يرمز له من تيه بني إسرائيل بعد خروجهم من الاستعباد في مصر (وفق الرواية التوراتية)، فما قدّمه الفيلم في عبور الـــ 40 ميل، يشبه إحدى حلقات المغامر البريطاني بيير جريلز، وهو يثبت للمشاهدين، بأنّه قادر على النجاة من مستنقع مليء بالتماسيح وحتى الساحرات! أمّا الجمل المهمّة التي تفوّه بها بيتر، وأكثرها جمل مستمدّة من الكتاب المقدس مع الإشارات الدينية العديدة التي قام بها، جعلتنا أمام واعظ ديني، لا قصة جوردن التي تقوم على أيقونة الظهر المحروث بالسياط.
تقع الأفلام التي تستند إلى قصة حقيقية في نفس المعضلة التي تقع فيها الأفلام التي تقوم على رواية ما. فما بين الميل لصالح حرية التخييل بمقابل الواقع، يظل الواقع متجذرًا يقدّم معطياته التي تؤثر على سير الفيلم، وحتى يتم التخلّص من هذا الشرك، لا بدّ من تقديم واقع مواز، نسخة توأم، لكن التشابه بين توأمين لا ينتج ذات الحياة لكليهما، فلكل منهما حياته المستقلّة. والأمر ذاته في الرواية عندما تقتبس فلميّا وإن لم يحدث ذلك، أصبح الاقتباس عاملًا مضادًا للفيلم المستوحى من الرواية. إنّ الذي حدث في فيلم الانعتاق أنّ صورة ظهر جوردن المحروث بالسياط من القوة والسطوة، بحيث تشطب إيّ استبعاد لها، وحتى إنتاج قصّة أخرى لها. وخاصة إذا تحوّلت إلى حصان طروادة يستطيع ويل سميث من خلاله جبّ صفعته على مسرح الأوسكار. في النهاية النوايا الحسنة لا تصنع أفلامًا جميلة، ولربما تكون صورة ظهر بيتر/ جوردن في الفيلم، هي حجر العقد في الفيلم، على الرغم من أنّها كانت أحد أسباب فشله، لأنّها لها القدرة على أن تدفع المشاهد للبحث عن سيرة هذا الظهر المحروث بالسياط بعيدًا عن محاولة تبييض صفحة ويل سميث.
باسم سليمان
خاص الصباح

January 3, 2023
عمارة النور؛ القوس العربي لا ينام أبدًا- مقالي في ضفة ثالثة – باسم سليمان
كان الحريق المؤسِف الذي أتى على كنيسة نوتردام في باريس في الخامس عشر من نيسان 2019، الدافع المضمر لإعادة بناء الكنيسة وفق روحيتها على الأقل بالكلمات، على يد الباحثة ديانا دارك في كتابها: (السرقة من المسلمين -السَّاراسِن- كيف شكّلت العمارة الإسلامية أوروبا، الصادر عن الدار العربية للعلوم ناشرون 2022)، بعد أن حذّرت الكاتبة بأنّ الاستعجال في بناء هذا الصرح سيفقده أصالته، وذلك بسبب غياب المعرفة بالجينات المعمارية التي سمت به. لقد عبّر الرئيس الفرنسي ماكرون عمّا يجول في ذهن الفرنسيين عن نوتردام بأن قال: بأنّها تمثل القومية الفرنسية خير تمثيل. تعتبر كنيسة نوتردام النموذج الكامل للعمارة القوطية التي انتشرت من فرنسا إلى بقية أصقاع أوروبا. وبناء على ذلك غرّدت دارك بأنّ الكنيسة ذات البناء القوطي تعود إلى العمارة الإسلامية، التي بدأت بقبة الصخرة ومن بعدها الجامع الأموي، مرورًا بآيا صوفيا ومسجد قرطبة والكثير من الأبنية الإسلامية، وخاصة قصور الصحراء التي بناها الخلفاء الأمويون في بلاد الشام، وذلك انطلاقًا من كنائس المدن المنسية في شمال غرب سورية في إدلب وجنوب حلب، ككنيسة قلب لوزة والقديس سمعان العامودي في الزمن البيزنطي. وعندما انتشرت تغريدة ديانا دارك تلقت الكثير من الاهتمام والاستهجان، وكأنّها أشعلت حريقًا آخر في رماد الكنيسة، فكان هذا الكتاب كشفًا للجذور العميقة في التاريخ التي انتصبت فوقها شجرة نوتردام.
لم ترغب دارك أن تسبح وحيدة في هذه اللّجة التاريخية، لذلك استحضرت كريستوفر رن، من القرن السابع عشر، أشهر معماريّ إنكلترا، فهو الباني لمسرح شيلدون بسقفه ذي الإنشاءات والتدعيمات المخفية عن الأعين، والتي قد استلهمها من جوامع إسطنبول، والأحرى من المهندس العثماني سنان، و هو أيضًا الباني لكنيسة سانت بول بقبتها الرائعة التي نراها كثيرًا في خلفية شاشة مذيعي الـــ BBC، والتي استوحى قبتها من كنسية الفاتيكان والبانثيون الإغريقي وبداية من كنيسة آيا صوفيا، حيث كانت كنيسة سمعان العامودي وقلب لوزة في الشمال السوري، الرحم التي ولدت منها كنيسة آيا صوفيا. لقد أعلن رن ضجره من العمارة القوطية فقد كان يعتبر العمارة الرومانسكية – الإغريقية والرومانية- مثالًا للتوازن والتماثل، في حين أنّ العمارة القوطية وبرغم جمالها الكبير، فقد كانت تفتقر إلى الصلابة التي رآها رن عيبًا في العمارة القوطية الأوروبية، لجهل في الرياضيات لدى المعماريين القوطيين، والتي لم تفت المعماريين المسلمين في جامع قرطبة أبدًا. لقد كان رن مطلعًا بشكل عميق على الثقافة المعمارية، لذلك كان صريحًا، بأنّ العمارة القوطية مصدرها من الساراسن/ المسلمين. وعلى الرغم من ذلك، لم يستطع رن أن يتخلّص من الحلول العملية والنظرية لعمارة المسلمين في مسرح شيلدون وكنيسة سانت بول، فقد مضوا بعيدًا في تطوير أسس فن الهندسة والعمارة. لقد حسم رن منذ القرن السابع عشر، حيث إرث الأندلسيين لم يزل طازجًا في الذاكرة، بأنّ أصول العمارة القوطية الأوروبية تدين بشكل واضح للعمارة العربية والمسلمة. ويشرح رن الفرق بين العمارة الرومانسكية والقوطية، بأنّ الأولى أفقية في حين الثانية عامودية، فما إن يضع المعماريون القوطيون القواعد حتى يشرعوا في البناء أعلى فأعلى. وقد منحهم القوس المدبّب وأنماطه الأخرى القدرة على ذلك، لأنّه لايحتاج إلى حجارة ارتكاز قوية كالقوس الروماني المدوّر. وفي الوقت نفسه يستطيع القوس المدبّب أن يحمل أقواسًا أخرى فوقه على ذات حجر الارتكاز، مما سمح بتلك الإنشاءات العالية التي نراها في الأبنية القوطية؛ وكما تقول العرب القوس لا ينام أبدًا.
من المسجد الأموي إلى كنيسة نوتردام:
بعد هذه الشهادة من كريستوفر رن التي تتوسّط الزمن بين آخر أيام عبد الله الصغير في الأندلس وحريق نوتردام في أيامنا، انطلقت دارك في تبيان المصادر المعمارية للأبنية القوطية في أوروبا. تعود دارك في الزمن إلى بدايات تاريخ المسيحية في بلاد الشام حيث تجد في كنيسة قلب لوزة ذات البرجين وبينهما القوس الذي يعلو الباب، الإرهاص الأول لكنيسة نوتردام ببرجيها ونافذتها الوردية. وبعد ذلك تعرج على قبة الصخرة حيث تظهر الانطلاقات السريعة والتغييرات الحاسمة فيما ورثه المسلمون من العمارة البيزنطية، فقد ظهر القوس المدبّب المطواع والقادر على تحمل أثقال كبيرة، وقوس حدوة الحصان والأوجي والقوس ذو الفصوص الثلاثة الذي أصبح ميزة للعمارة القوطية بسبب المبدأ الديني المسيحي، مضافًا إلى ذلك الفسيفساء التي كست المظهر الخارجي للقبة. وعندما دخل الصليبيون القدس اعتبروا القبة هيكل سليمان والمسجد الأقصى قصره، لذلك اتخذوهما معيارًا إلى جانب التطورات الحاسمة في الإنشاءات المعمارية التي طورها المسلمون، حتى أنّهم استنسخوا الخط الكوفي منها كزينة لأبنيتهم القوطية .
تقتفي دارك أثر البدايات المعمارية التي قام المسلمون بها، أسواء كان مصدرها من البيزنطيين أو الفرس أو من التزيينات التي لحظوها في آثار بلاد الرافدين، والتي قاموا بتطويرها بشكل جذري، وتم تطبيقها في المسجد الأموي ومآذنه، وخاصة فتحات الرمي في قلعة دمشق والتي استنسخها الصليبيون في قلعة الحصن. كانت قصور الأمويين في البادية وخصوصًا قصر خربة المفجَر قرب أريحا، تحتوي على كل ما يلفت النظر في العمارة القوطية، كما تبيّن من الحفريات التي قام بها الآثاري روبرت هاملتون القيم على متحف أوكسفورد إبان الاحتلال البريطاني لفلسطين، بأنّ قصر خربة المفجر يمثّل ألف باء العمارة التي انتشرت على يد الأمويين، وصولًا إلى الأندلس مع عبد الرحمن الداخل ومسجد قرطبة الذي كان يعتبر الكتاب الهندسي للعمارة القوطية من أعمدة وقبب وأقواس وزخارف وفسيفساء.
تعتبر النافذة الوردية في واجهات الكنائس القوطية ميزة مستمرة فيها، وقد وجدت في كنيسة نوتردام. هذه النافذة الوردية بزخارفها تظهر بشكل جلي في قصر المفجر الذي بناه هشام بن عبد الملك. لقد طوّر الأمويون عمارة الأقواس بشكل علمي قبل أن ينقلوا هذه الذخيرة المعمارية معهم إلى الأندلس. فمن خلال الأقواس بنوا قببًا عالية، وتحكموا بالحمولات الثقيلة واستطالوا بقببهم ومآذنهم نحو السماء أكثر فأكثر.
تمتاز قبة الصخرة بالنوافذ الفسيفسائية المصنوعة من الزجاج، حيث تؤمّن إضاءة داخلية خلابة. هذه النوافذ الكبيرة وما تحمله من معان مضمرة عن النور الإلهي وجدت طريقها إلى الكنائس. وعندما قام الأب سوجير بتوسعة كنيسة القديس كلوني، أمر بهدم الأبراج في الجهة الغربية واستبدالها بجدران أرق تتوسطها نافذة وردية مؤطّرة بشكل مربع، وكثيرًا ما كان العرب يستخدمون التأطير بالأشكال الهندسية في تزييناتهم. لقد اكتمل بناء كنيسة سان دوني عام 1140وسرعان ما انتشر تقليد النافذة الوردية في بقية الكنائس. وبعد ذلك أراد سوجير أن يعيد بناء القسم الشرقي من الكنيسة وخاصة مكان الجوقة، لذلك استلهم السقف ذا الأضلاع المعروف في مسجد قرطبة والنوافذ الفسيفسائية الزجاجية لإضاءة أكبر. لقد كان سوجير متأثرًا بكتابات السوري دينيس عن النور الإلهي، وما كان له أن يجعل المعنى اللاهوتي حسيّا إلّا من خلال استخدام القوس المدبب والسقف ذي الأضلاع اللذين يسمحان بأكبر توسعة للنوافذ الفسيفسائية. وهكذا أصبحت سانت كلوني أول عمارة قوطية في أوروبا، وتم استنساخ هندستها في بقية الكنائس والأبنية. إنّ صناعة الزجاج التي اشتهر بها الفينيقيون ومن بعدهم العرب والتي زينت كنائس وأبنية البندقية وغيرها من الأبنية القوطية، وجدت قطعها صامدة في رماد كنيسة نوتردام.
“لا يكون أيّ رجُل جزيرة”:
هذه العبارة تعود للكاهن الشاعر جون دون الذي كان فيما مضى عميدًا لكنيسة سانت بول وتكاد تكون الغاية من كتابة هذا الكتاب. لقد انطلقت دارك بشكل استفزازي من خلال عنوان كتابها متهمة الغرب بسرقة (الساراسن) وهذه الكلمة تعني: السرّاق، وقد كانت لفظ ازدرائي من قبل الأوروبيين بحق العرب والمسلمين. وهي بهذا العنوان تثير معان مضمرة؛ فيا أيّها الأوروبيون الذين تتهمون المسلمين بأنّهم لصوص، بماذا تختلفون عنهم، وأنتم تنكرون أصول عمارتكم التي تفخرون بها أيما فخر، والتي تعود جملة وتفصيلًا إلى هؤلاء الساراسن/ السرّاق. إنّ ما قصدته دارك بأنّ الحضارات تستلهم من بعضها البعض، ولا أحد يستطيع أن ينكر فضل حضارة على أخرى، لكن ذلك لم يكن ليتوضح إلّا بعرضها للعمارة في بلاد الشام، والتي كانت الأرض التي أحكم عليها المسلمون قبضتهم من بعد البيزنطيين، فالعمارة الإسلامية لم تبتدع منشآتها من العدم، فالأقواس الرومانية الدائرية والثلم التزيينية في أعلى الأسوار والزخارف الورقية والفسيفساء والقبب والجملونات والنوافذ كانت متواجدة، ومنها انطلق الأمويون عبر جمع ومزج هذه الإنشاءات الهندسية ليبنوا من خلالها، وعبر تطويرها مجدهم المعماري. لقد بدأ التأثير المعماري العربي على أوروبا قبل الحروب الصليبية من خلال الأندلس وصقلية، لكن من خلال الحروب الصليبية تركّز تأثير العمارة العربية على العمارة في أوروبا، فظهرت في أسلوب عمارتهم بشكل واضح وجليّ، والذي دعي بالقوطي تمييزًا له عن العمارة السابقة عليه الرومانية واليونانية.
لا يمكن الإحاطة بكل ما أوردته دارك في سعيها لإثبات النسب الحقيقي للعمارة القوطية إلى رحم العمارة العربية، فلم يكن العرب ناقلي معرفة فقط، بل كانوا صانعيها ومطوّريها. وكما ارتبطت فلسفة دينيس السوري عن النور بالعمارة القوطية في الغرب، نستطيع أن نفهم لماذا عنونت المستشرقة زيغريد هونكه كتابها: شمس العرب تسطع على الغرب.
باسم سليمان
خاص ضفة ثالثة

https://diffah.alaraby.co.uk/diffah//civilisation/2023/1/3/%D8%B9%D9%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%D9%D9%D8%B1-%D8%A7%D9%D9%D9%D8%B3-%D8%A7%D9%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%D8%A7-%D9%8A%D9%D8%A7%D9-%D8%A3%D8%A8%D8%AF%D8%A7 https://diffah.alaraby.co.uk/diffah//civilisation/2023/1/3/%D8%B9%D9%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%D9%D9%D8%B1-%D8%A7%D9%D9%D9%D8%B3-%D8%A7%D9%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%D8%A7-%D9%8A%D9%D8%A7%D9-%D8%A3%D8%A8%D8%AF%D8%A7
December 29, 2022
الببغاء مهرج الغابة – ديوان شعر – باسم سليمان – رابط تنزيل على موقع أكاديمية
December 18, 2022
أبشالوم أبشالوم، أيّها الجنوبي، اُسرُدْ لنا رواية الحرب والعبودية – مقالي في ضفة صالثة – باسم سليمان
تحاول الروايات المعاصرة أنْ تمحو الثيمة المتكرّرة في القصص القديمة، التي تقوم على الرغبة بإخبار القصص، وكل ذلك من أجل موضوعية متوّهمة! لم تكن القصص القديمة تخفي هذه الرغبة بل تعلنها صراحة كي تتحصّل المعرفة والاعتبار، كما في الإلياذة والأوديسة وألف ليلة وليلة وغيرها الكثير. هذه الرغبة الملحاحة للقصّ والاستماع لم يبعدها وليم فوكنر في روايته، أبشالوم أبشالوم، الصادرة عن دار المدى لعام 2022 بترجمة سيزار كبيبو، بل أظهرها في العديد من المرات في روايته، وبشكل واضح عندما طلبت روزا كولدفيلد من كونتن أن يروي حكاية توماس ستبن، ومن خلاله تسرد حكاية الحرب الأهلية وتاريخ العبودية. وحدث ذات الأمر عندما أراد الطالب الشمالي شريف أن يعرف ما هو الجنوب الأمريكي، فوجه سؤاله لكونتن؛ هذا الجنوبي: ما هو الجنوب؟ إن سؤال شريف الآتي من الشمال، ليس إلّا سؤال وليم فوكنر المولود في الجنوب الأمريكي. هذا المنشأ هو الذي يبرّر تلك الرغبة في أن تسرد الروايات وتقصّ الحكايات، لتتحقّق المعرفة بما حدث.
هذا التركيز على حكاية الجنوب الأمريكي لا يمكن أن تعقل، إلا من أجل إدراك وفهم الأسباب التي أشعلت حربًا أهلية في منتصف القرن التاسع عشر، وما تزال تومض من بعيد بإمكانية تكرارها. إنّ وعي هذا الخطر، هو ما دفع وليم فوكنر لتناول الجنوب الأمريكي في روايته هذه وسابقا في رواية الصخب والعنف، حتى أنّه أحيا شخصيات من الصخب والعنف لتكون شاهدة وراوية لسيرة حياة توماس ستبن الشيطانية، وكأنّه يقول: هل عرفتم السبب في فنائكم الآن! لقد مات كل من الشاب كونتن كمبسن ووالده في رواية الصخب والعنف وانتهت عائلتهما نهاية مأساوية، وبشكل آخر، هذا ما حدث مع عائلة توماس ستبن، فماهو المرض المستعصي الذي يضرب عائلات الجنوب ويحوّل بيوتها ومزارعها إلى ظلام وعنف؟
تبدأ رواية فوكنر في أوائل القرن العشرين، عندما كان كمبسن الابن يستعد للالتحاق بالجامعة عبر استدعائه من قبل روزا كولدفيلد لتحكي له – بعد 43 سنة- كيف ظهر الشيطان توماس ستبن من العدم مع زنوجه. وذلك في صباح الأحد من شهر حزيران عام 1833، ليأسّسوا مرزعة ستبن، التي تمتد على مساحة مئة ميل، كان قد استولى عليها بطريقة ما من أحد زعماء الهنود العجائز، ومن ثم بدأ بالتقرّب من عائلة كولدفيلد لينال القبول الاجتماعي وكان له هذا، فتزوج من إلين كولدفيلد، وأنجب منها ابنًا وابنة؛ هنري وجوديث. تأخرت ولادة روزا كولدفيلد كثيرًا عن أختها إلين، فقد كانت أصغر من ولديها هنري وجوديث، ويأتي طلب إلين التي كانت على فراش الموت من أختها روزا الصغيرة أن تهتم بولديها الأكبر منها سنّا، القطبة التي رتقت روزا بشكل قدري عنيف إلى عائلة ستبن. تريد روزا من كونتن أن يكون شاهدًا وراويًا على حياة توماس ستبن الجهنمية، لكن في الوقت نفسه راويًا لأسباب هزيمة الجنوب، فروزا التي ملأت الصحف في ذلك الوقت بالأشعار البطولية والرثاء لمن ابتلعتهم الحرب كانت تريد من كونتن الشاب الذي مازال في مقتبل العمر، أن يلعب دور الأنثروبولوجي الكاشف عن أسباب هزيمة الجنوب، وخاصة مع الاعتقاد في ذلك الزمن بأنّ الحروب تربح على أساس أخلاقي.
البيت المظلم، أو أبشالوم أبشالوم:
لم يكن عنوان رواية فوكنر بداية، أبشالوم أبشالوم، بل البيت المظلم! هذا الاستبدال تم بسبب سطوة المضمون في الرواية على عتبتها العنوانية، فالتناص بين أبشالوم ابن داود في التوارة وهنري ابن توماس ستبن يتبدّى تدريجيًّا في الرواية مع ظهور تشارلز بون الأخ غير الشقيق لهنري وجوديث من ثنيات التاريخ الغامض لتوماس والذي سيلعب دور العريس المستقبلي لجوديث، حيث تظهر ثيمة زنا المحارم، فقد اغتصب أمنون الأخ غير الشقيق لأبشالوم أخته ثامار وبسبب ذلك قتله أبشالوم، فهرب على إثر ذلك من وجه أبيه داود الذي أغوى امرأة أوريا الحثي، ودفع بزوجها إلى مقدمة الجيش كي يموت كما جاء في سفر صموئيل 1- 2. تنتهي قصة أبشالوم في التوراة بقتله على يد جنود داود وساعتها يُسمع صراخ داود متفجعًا على ابنه: أبشالوم، أبشالوم، يا ابني أبشالوم. لم يستحضر فوكنر التناص مع التوراة إلّا ليؤكد أن تعاملنا المقدس مع الماضي هو الذي يعيد إنتاجه، وكما يقول في روايته، قداس لراهبة: “الماضي لم يمت أبدًا. إنّه ليس ماضيًا”.
لم يكن تصوير مجيء ستبن إلى بلدة جفرسون، على هيئة قادم من المجهول، ومن ثم بناء مزرعته عبر كفاح لا يلين، إلّا لإظهار الرغبة القاتلة في وجدان ستبن أن يُلحظ كرجل عصامي لا شائبة تعكّر ماضيه، لكن ظهور ابنه تشارلز بون قوّض مشروعه عبر ارتداد ماضيه على حاضره. هذا المستنقع المأساوي لا يختلف كثيرًا عن الأرض التي استصلحها ستبن، وبنى عليها بيته الفاخر الذي دخل الحرب ضد الشمال من أجله وعاد خاسرًا، ليقتله أحد عبيده المخلصين.
لقد كانت كل شخصية في الرواية تنتج نسختها الخاصة مستبعدة ومدمجة في الوقت نفسه مع روايات الشخصيات الأخرى. هكذا كان ستبن وفق رواية جدّ كونتن رجلًا يستحق التقدير، وفي حكاية روزا كان كالشيطان، أمّا لدى كونتن، فلا تستطيع الحكم على توماس ستبن، فالتاريخ لم ينته بعد. قام أبشالوم بقتل أخيه أمنون بعد اغتصابه ثامار، لكن لماذا لم يُغضب هذا الاغتصاب داود، وبدلًا من ذلك صب جام غضبه على حامي الشرف! هل لأنّه كان قد دفع بأحد جنوده المخلصين للموت كي يتزوّج زوجته، وينجب منها سليمان ملك الملوك؟ مهما يكن، فلقد أراد فوكنر من هذا المستنقع السردي أن يدفع بالقارئ أن يلعب دوره، فيصبح مثل كونتن في آخر الرواية قارئًا وراويًا، وناقدًا أيضًا.
هذه المأساة التوراتية تعيد ذاتها وفق قاعدة الماضي الذي لا يموت أبدًا، ليس ماضيًا. عاد ماضي توماس ستبن للظهور، لأن حاضره يستند إليه وفق آلية ارتباط الفرع بالأصل وسنسمع من جديد صرخة توماس ستبن المتفجعة على ابنه: هنري، هنري، يا ابني هنري.
بين مارغريت ميتشل ووليم فوكنر:
صدرت رواية فوكنر في عام 1936 وهو ذات العام الذي صدرت فيه رواية ذهب مع الريح لمارغريت ميتشل، التي نالت عنها جائزة البوليتزر. تعتبر رواية ميتشل من الروايات المناهضة لرواية كوخ العم توم لهارييت بيتشر ستو، التي فضحت العبودية، فعندما التقى أبراهام لنكولن بهارييت، قال لها وفق جوناثان غوتشل في كتابه؛ الحيوان الحكاء: “إذن، أنت المرأة الصغيرة مؤلفة الكتاب الذي أشعل الحرب الأهلية”. إنّ رواية ميتشل رواية تصالحية وتجميلية مع تاريخ الجنوب والحرب الأهلية، لكنّ فوكنر لم يكن من مؤيدي هذا الاتجاه، فهو مازال يرى الماضي حاضرًا والعنصرية والعبودية لم تنته، بل تتمظهر بأدوار أخرى، لذلك لم يجمّل ماضي الجنوب، بل فضح الجميع من بيض وسود، وفق نسبة مسؤوليتهم عن الذي حدث ومازال يحدث. إنّ ثورة الزنجي ووش على سيده ستبن وشطره إياه نصفين بالمنجل، جاءت متأخرة جدًا، حتى لو كان سببها أن ستبن لم يفكر للحظة بتلك الصغيرة السوداء التي راهن عليها لتنجب له ذكرًا غير أصيل العرق! فأنجبت له بنتًا، ستصطف مع ابنته الأخرى الزنجية كليتي في زريبة أحصنته الخاسرة.
لا يريد فوكنر تنقيح تاريخ الجنوب الأمريكي، لذلك سمح للجميع أن يسرد زاويته من الرؤية، تاركًا القارئ/كونتن ينبش في ركام سرد وريثة بيت الظلام روزا المتقطّع والمفكّك. والسرد الخطي مع الجد كمبسن ومن ثم إعادة تشكيل سردية عائلة ستبن مع كونتن وصديقه شريف، وكل ذلك لأجل أن لا يعاد بناء بيت الظلام في أمريكا.
لا يحسم فوكنر شيئّا في روايته، إنْ كان حقًا يسرد سيرة حياة توماس ستبن، لكنه يؤكد أنّ العَوْد الدوري للتاريخ الأمريكي، سيتكرّر ما دام الماضي يُعاد إحياؤه كمستقبل بشكل أو بآخر. هذا ما أدركه كونتن القارئ وشريف المستمع للحكاية، فرويدًا رويدًا يدخلان كشخصيتين فاعلتين في سرد فوكنر تحقيقًا وفهمًا لرغبة روزا بأنْ يحمل كونتن وصية، أن يروي الحكاية ليفهم، لماذا هُزِم الجنوب من خلال قول روزا الذي كشف عن العطب الوجودي في حياة الجنوب الأمريكي: “فالرجال الجنوبيون، كانوا من ذوي الشجاعة والقوة، لكن من دون شفقة أو شرف!”. لقد كان كونتن وريث هذا التاريخ مثله مثل أي أمريكي آخر، مهما بدا له أنّه بعيد تمامًا عن أحداث الماضي، فاستفسار كونتن في البداية من أبيه عن الأسباب التي دفعت روزا لاختياره، لتقصّ له حياة ستبن، يلقى جوابه أخيرًا عبر إدراك لماذا حمّلته روزا هذه الوصية السم/ الترياق، كي لا يكون هناك أبشالوم آخر، والأحرى توماس ستبن جديد.
إنّ أبشالوم أبشالوم، هي رواية عن الجنوب الأمريكي والحرب الأهلية والإرث السيئ للعبودية، وعدم قدرة الجنوب على المضي نحو المستقبل، ما لم يتقبّل حقيقة أنّ الصراع بين الأعراق مقتل وجودي.
باسم سليمان
خاص ضفة ثالثة
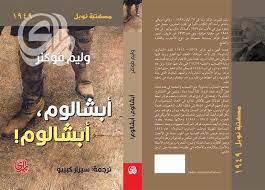
أبشالوم، أيّها الجنوبي، اُسرُدْ لنا رواية الحرب والعبودية – مقالي في ضفة صالثة – باسم سليمان
تحاول الروايات المعاصرة أنْ تمحو الثيمة المتكرّرة في القصص القديمة، التي تقوم على الرغبة بإخبار القصص، وكل ذلك من أجل موضوعية متوّهمة! لم تكن القصص القديمة تخفي هذه الرغبة بل تعلنها صراحة كي تتحصّل المعرفة والاعتبار، كما في الإلياذة والأوديسة وألف ليلة وليلة وغيرها الكثير. هذه الرغبة الملحاحة للقصّ والاستماع لم يبعدها وليم فوكنر في روايته، أبشالوم أبشالوم، الصادرة عن دار المدى لعام 2022 بترجمة سيزار كبيبو، بل أظهرها في العديد من المرات في روايته، وبشكل واضح عندما طلبت روزا كولدفيلد من كونتن أن يروي حكاية توماس ستبن، ومن خلاله تسرد حكاية الحرب الأهلية وتاريخ العبودية. وحدث ذات الأمر عندما أراد الطالب الشمالي شريف أن يعرف ما هو الجنوب الأمريكي، فوجه سؤاله لكونتن؛ هذا الجنوبي: ما هو الجنوب؟ إن سؤال شريف الآتي من الشمال، ليس إلّا سؤال وليم فوكنر المولود في الجنوب الأمريكي. هذا المنشأ هو الذي يبرّر تلك الرغبة في أن تسرد الروايات وتقصّ الحكايات، لتتحقّق المعرفة بما حدث.
هذا التركيز على حكاية الجنوب الأمريكي لا يمكن أن تعقل، إلا من أجل إدراك وفهم الأسباب التي أشعلت حربًا أهلية في منتصف القرن التاسع عشر، وما تزال تومض من بعيد بإمكانية تكرارها. إنّ وعي هذا الخطر، هو ما دفع وليم فوكنر لتناول الجنوب الأمريكي في روايته هذه وسابقا في رواية الصخب والعنف، حتى أنّه أحيا شخصيات من الصخب والعنف لتكون شاهدة وراوية لسيرة حياة توماس ستبن الشيطانية، وكأنّه يقول: هل عرفتم السبب في فنائكم الآن! لقد مات كل من الشاب كونتن كمبسن ووالده في رواية الصخب والعنف وانتهت عائلتهما نهاية مأساوية، وبشكل آخر، هذا ما حدث مع عائلة توماس ستبن، فماهو المرض المستعصي الذي يضرب عائلات الجنوب ويحوّل بيوتها ومزارعها إلى ظلام وعنف؟
تبدأ رواية فوكنر في أوائل القرن العشرين، عندما كان كمبسن الابن يستعد للالتحاق بالجامعة عبر استدعائه من قبل روزا كولدفيلد لتحكي له – بعد 43 سنة- كيف ظهر الشيطان توماس ستبن من العدم مع زنوجه. وذلك في صباح الأحد من شهر حزيران عام 1833، ليأسّسوا مرزعة ستبن، التي تمتد على مساحة مئة ميل، كان قد استولى عليها بطريقة ما من أحد زعماء الهنود العجائز، ومن ثم بدأ بالتقرّب من عائلة كولدفيلد لينال القبول الاجتماعي وكان له هذا، فتزوج من إلين كولدفيلد، وأنجب منها ابنًا وابنة؛ هنري وجوديث. تأخرت ولادة روزا كولدفيلد كثيرًا عن أختها إلين، فقد كانت أصغر من ولديها هنري وجوديث، ويأتي طلب إلين التي كانت على فراش الموت من أختها روزا الصغيرة أن تهتم بولديها الأكبر منها سنّا، القطبة التي رتقت روزا بشكل قدري عنيف إلى عائلة ستبن. تريد روزا من كونتن أن يكون شاهدًا وراويًا على حياة توماس ستبن الجهنمية، لكن في الوقت نفسه راويًا لأسباب هزيمة الجنوب، فروزا التي ملأت الصحف في ذلك الوقت بالأشعار البطولية والرثاء لمن ابتلعتهم الحرب كانت تريد من كونتن الشاب الذي مازال في مقتبل العمر، أن يلعب دور الأنثروبولوجي الكاشف عن أسباب هزيمة الجنوب، وخاصة مع الاعتقاد في ذلك الزمن بأنّ الحروب تربح على أساس أخلاقي.
البيت المظلم، أو أبشالوم أبشالوم:
لم يكن عنوان رواية فوكنر بداية، أبشالوم أبشالوم، بل البيت المظلم! هذا الاستبدال تم بسبب سطوة المضمون في الرواية على عتبتها العنوانية، فالتناص بين أبشالوم ابن داود في التوارة وهنري ابن توماس ستبن يتبدّى تدريجيًّا في الرواية مع ظهور تشارلز بون الأخ غير الشقيق لهنري وجوديث من ثنيات التاريخ الغامض لتوماس والذي سيلعب دور العريس المستقبلي لجوديث، حيث تظهر ثيمة زنا المحارم، فقد اغتصب أمنون الأخ غير الشقيق لأبشالوم أخته ثامار وبسبب ذلك قتله أبشالوم، فهرب على إثر ذلك من وجه أبيه داود الذي أغوى امرأة أوريا الحثي، ودفع بزوجها إلى مقدمة الجيش كي يموت كما جاء في سفر صموئيل 1- 2. تنتهي قصة أبشالوم في التوراة بقتله على يد جنود داود وساعتها يُسمع صراخ داود متفجعًا على ابنه: أبشالوم، أبشالوم، يا ابني أبشالوم. لم يستحضر فوكنر التناص مع التوراة إلّا ليؤكد أن تعاملنا المقدس مع الماضي هو الذي يعيد إنتاجه، وكما يقول في روايته، قداس لراهبة: “الماضي لم يمت أبدًا. إنّه ليس ماضيًا”.
لم يكن تصوير مجيء ستبن إلى بلدة جفرسون، على هيئة قادم من المجهول، ومن ثم بناء مزرعته عبر كفاح لا يلين، إلّا لإظهار الرغبة القاتلة في وجدان ستبن أن يُلحظ كرجل عصامي لا شائبة تعكّر ماضيه، لكن ظهور ابنه تشارلز بون قوّض مشروعه عبر ارتداد ماضيه على حاضره. هذا المستنقع المأساوي لا يختلف كثيرًا عن الأرض التي استصلحها ستبن، وبنى عليها بيته الفاخر الذي دخل الحرب ضد الشمال من أجله وعاد خاسرًا، ليقتله أحد عبيده المخلصين.
لقد كانت كل شخصية في الرواية تنتج نسختها الخاصة مستبعدة ومدمجة في الوقت نفسه مع روايات الشخصيات الأخرى. هكذا كان ستبن وفق رواية جدّ كونتن رجلًا يستحق التقدير، وفي حكاية روزا كان كالشيطان، أمّا لدى كونتن، فلا تستطيع الحكم على توماس ستبن، فالتاريخ لم ينته بعد. قام أبشالوم بقتل أخيه أمنون بعد اغتصابه ثامار، لكن لماذا لم يُغضب هذا الاغتصاب داود، وبدلًا من ذلك صب جام غضبه على حامي الشرف! هل لأنّه كان قد دفع بأحد جنوده المخلصين للموت كي يتزوّج زوجته، وينجب منها سليمان ملك الملوك؟ مهما يكن، فلقد أراد فوكنر من هذا المستنقع السردي أن يدفع بالقارئ أن يلعب دوره، فيصبح مثل كونتن في آخر الرواية قارئًا وراويًا، وناقدًا أيضًا.
هذه المأساة التوراتية تعيد ذاتها وفق قاعدة الماضي الذي لا يموت أبدًا، ليس ماضيًا. عاد ماضي توماس ستبن للظهور، لأن حاضره يستند إليه وفق آلية ارتباط الفرع بالأصل وسنسمع من جديد صرخة توماس ستبن المتفجعة على ابنه: هنري، هنري، يا ابني هنري.
بين مارغريت ميتشل ووليم فوكنر:
صدرت رواية فوكنر في عام 1936 وهو ذات العام الذي صدرت فيه رواية ذهب مع الريح لمارغريت ميتشل، التي نالت عنها جائزة البوليتزر. تعتبر رواية ميتشل من الروايات المناهضة لرواية كوخ العم توم لهارييت بيتشر ستو، التي فضحت العبودية، فعندما التقى أبراهام لنكولن بهارييت، قال لها وفق جوناثان غوتشل في كتابه؛ الحيوان الحكاء: “إذن، أنت المرأة الصغيرة مؤلفة الكتاب الذي أشعل الحرب الأهلية”. إنّ رواية ميتشل رواية تصالحية وتجميلية مع تاريخ الجنوب والحرب الأهلية، لكنّ فوكنر لم يكن من مؤيدي هذا الاتجاه، فهو مازال يرى الماضي حاضرًا والعنصرية والعبودية لم تنته، بل تتمظهر بأدوار أخرى، لذلك لم يجمّل ماضي الجنوب، بل فضح الجميع من بيض وسود، وفق نسبة مسؤوليتهم عن الذي حدث ومازال يحدث. إنّ ثورة الزنجي ووش على سيده ستبن وشطره إياه نصفين بالمنجل، جاءت متأخرة جدًا، حتى لو كان سببها أن ستبن لم يفكر للحظة بتلك الصغيرة السوداء التي راهن عليها لتنجب له ذكرًا غير أصيل العرق! فأنجبت له بنتًا، ستصطف مع ابنته الأخرى الزنجية كليتي في زريبة أحصنته الخاسرة.
لا يريد فوكنر تنقيح تاريخ الجنوب الأمريكي، لذلك سمح للجميع أن يسرد زاويته من الرؤية، تاركًا القارئ/كونتن ينبش في ركام سرد وريثة بيت الظلام روزا المتقطّع والمفكّك. والسرد الخطي مع الجد كمبسن ومن ثم إعادة تشكيل سردية عائلة ستبن مع كونتن وصديقه شريف، وكل ذلك لأجل أن لا يعاد بناء بيت الظلام في أمريكا.
لا يحسم فوكنر شيئّا في روايته، إنْ كان حقًا يسرد سيرة حياة توماس ستبن، لكنه يؤكد أنّ العَوْد الدوري للتاريخ الأمريكي، سيتكرّر ما دام الماضي يُعاد إحياؤه كمستقبل بشكل أو بآخر. هذا ما أدركه كونتن القارئ وشريف المستمع للحكاية، فرويدًا رويدًا يدخلان كشخصيتين فاعلتين في سرد فوكنر تحقيقًا وفهمًا لرغبة روزا بأنْ يحمل كونتن وصية، أن يروي الحكاية ليفهم، لماذا هُزِم الجنوب من خلال قول روزا الذي كشف عن العطب الوجودي في حياة الجنوب الأمريكي: “فالرجال الجنوبيون، كانوا من ذوي الشجاعة والقوة، لكن من دون شفقة أو شرف!”. لقد كان كونتن وريث هذا التاريخ مثله مثل أي أمريكي آخر، مهما بدا له أنّه بعيد تمامًا عن أحداث الماضي، فاستفسار كونتن في البداية من أبيه عن الأسباب التي دفعت روزا لاختياره، لتقصّ له حياة ستبن، يلقى جوابه أخيرًا عبر إدراك لماذا حمّلته روزا هذه الوصية السم/ الترياق، كي لا يكون هناك أبشالوم آخر، والأحرى توماس ستبن جديد.
إنّ أبشالوم أبشالوم، هي رواية عن الجنوب الأمريكي والحرب الأهلية والإرث السيئ للعبودية، وعدم قدرة الجنوب على المضي نحو المستقبل، ما لم يتقبّل حقيقة أنّ الصراع بين الأعراق مقتل وجودي.
باسم سليمان
خاص ضفة ثالثة
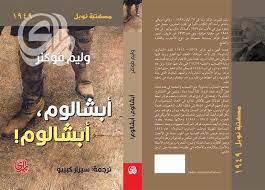
December 10, 2022
حظره الخليفة وذكره الشعراء برموز إيروتيكية… الشّطرنج في التراث العربي
يقول أينشتاين: “أنا على يقين تام بأنّ الله لا يلعب النرد”. وما يقصده إينشتاين أنّ الكون منظم بدقة وإن لم نكن نفهم هذا التنظيم. وإنْ كان لنا أن نزيد على قول أينشتاين: لربما كان الله يلعب الشطرنج. إنّ الفرق بين لعبتي الشطرنج والنرد؛ أنّ الأولى تقوم على إعمال العقل وتدبّر الخطط والتأمّل والتفكير قبل الإقدام على أية حركة، في حين تقوم الثانية على رمي حجر النرد، خبط عشواء، وانتظار ما تستقرّ عليه أوجه النرد من أرقام، فلا تدبر فيها ولا تفكير، بل خضوع كامل لمشيئة النرد. قيل الكثير في أصل الشطرنج وفي أي بلد اخترع، فالإغريق قالوا بأنّ أحد قادة اليونانيين قد اخترعه في حصار طروادة لتسلية جنوده. بينما قال بهاء الدين العاملي في كتابه الكشكول، بأنّ الحكماء قد وضعوه لملوك الفرس والروم، لأنّهم لم يكونوا يطيلون الجلوس مع العلماء وذلك بسبب جهلهم. وإن اجتمعوا كانوا ينظرون إلى بعضهم البعض شزرًا، فاخترعوا لهم الشطرنج حتى ينشغلوا به.
مهما يكن من نسب الشطرنج لهذا البلد أو ذاك الشعب، فالأرجح أنه ذو منشأ هندي. يورد الفردوسي في الشهنامة قصة جميلة عن سبب اختراع الشطرنج. زعموا أنه في بلاد الهند كان هناك ملك اسمه جَمهور أنجب ولدًا واسماه كو، لكنه مات فتزوجت أرملته أخاه وأنجبت منه ولدًا اسمته طلخند ولم يعمّر الزوج الجديد، فلحق بأخيه الملك جَمهور إلى القبور. وهنا أصبحت الملكة وريثة للعرش ووصية على الولدين اللذين شبّا سريعًا وما لبثا أن طالب كل منهما بالعرش. وكان كو عاقلًا متزنًا، أمّا طلخند، فقد كان على عكس من ذلك. ولم تلبث أن تحزّبت البلاد بين الأخوين، ودارت المعارك بينهما، بعدما يأس كو أن يركن أخوه للعقل والتدبّر، أوصى قادته وجنوده ألا يتعرضوا لأخيه بالسوء، على عكس ما أمر به طلخند قادته وجنوده. وعندما انكشف غبار المعارك ألف طلخند نفسه وحيدًا فمات كمدًا وغضبًا. أصاب موت طلخند الملكة بالحزن والغضب، ولكي يشرح لها الأمير كو بأنّه لم يقتل أخاه، بل إنّ الملوك تموت حتف أنفها،عندما تفقد مواطن قوتها من عسكر ومال، مثّل لها ذلك بأن اخترع لعبة الشطرنج.
الحاضر يعلم الغائب اللعب بالشطرنج ممنوع:
كان مروان بن محمد الملقّب بالحمار آخر خلفاء بني أمية، ولا يعتبر هذا اللقب ذمًا له، بل دلالة على صبره على الشدائد. لقد حكم إمبراطورية تمتدّ من مشرق الشمس إلى مغربها في العالم القديم، حيث ورث التركة الأموية بغرمها وغنمها أي بإيجابياتها وسلبياتها، فلم يكن زمنه عهد استقرار، بل زمن فتن وثورات وخروج على الحكم. لم يكن مروان بن محمد خليفة ضعيفًا، فلقد اشتهر بالدهاء والبطش والشجاعة والإقدام، لكن الرياح كانت تجري على عكس ما تشتهي سفنه. وقد أوجز المسعودي في وصف حال هذا الخليفة بالقول بأنه كان: “يلقى أموره وهي مدبرة، ويريد أن يجعلها مقبلة” ومن تدبر عنه الدنيا فلا نجاة له. وأمام هذا الواقع فتّش الخليفة في الأسباب التي رأى أنها منذرة بعواقب وخيمة، فأمر كاتبه عبد الحميد الكاتب أن يوجه كتابًا إلى أحد حكّام الأقاليم يأمره بأن ينهي الناس عن اللعب بالشطرنج، لأن الشيطان كان قد زين لهم اللعب فيه كما جاء في كتاب رسائل البلغاء: “فكان مما قدم إليهم فيه نهيه وأعلمهم سوء عاقبته… وأوعز إليهم ناهيًا وواعظًا وزاجرًا الاعتكاف على هذه التماثيل من الشطرنج والمواصلة عليها لما في ذلك من عظيم الإثم…وقد بلغ أمير المؤمنين أن ناسًا ممن قبلك من أهل الإسلام قد ألهجهم الشيطان بها وجمعهم عليها وألف بينهم فيها معتكفون عليها من لدن صباحهم حتى ممساهم…” تكشف لنا رسالة عبد الحميد في الشطرنج كيف أنّ الشطرنج قد شغل المسلمين عن صلواتهم وأعمالهم لذلك كان لا بدّ من إطلاق يد الشرطة فيهم: “وتقدّم إلى عامل شرطتك في انهاك العقوبة لمن رفع إليه من أهل الاعتكاف عليها والإظهار للعب بها وإطالة حبسه في ضيق وضنك…ولا يجدن أحد عندك هوادة في التقصير في حق الله عز وجل…”. لا نستطيع القول بأنّ الخليفة مروان بن محمد قد شرعن قراره بمنع الشطرنج على تحريم فقهي، لكن كان للفقيه مالك بن أنس رأي يدل على كراهته: “لا خير فيه، وليس بشيء، وهو من الباطل، واللعب كله باطل” ولربما يضاف إلى أسباب هذه الكراهة بأن أحجار الشطرنج كانت على هيئة تماثيل مجسمة. ليس غريبا هذا التوجه الديني فقد جاء في مجلة الهلال بأن هناك وثيقة في الفاتيكان تعود إلى عام 1061 ورد فيها بأن الشطرنج ينافي الحكمة والقيام بالواجب وذلك أن يستولي الغرور على راهب، فيضيع أوقاته في لعب الشطرنج، وينتهك المقدسات بلعبة تلوث اليد واللسان اللذين يجب أن يستعملهما في خدمة الرب. مهما يكن من أمر كراهة الشطرنج أو تحريمه فقد رأى د. إحسان عباس الذي حقق رسائل عبد الحميد الكاتب الذي عمل تحت يد الخليفة مروان بن محمد ومن ضمنها رسالته التي تتضمن حظر الشطرنج، بأن هذا القرار يعود إلى أن أغلب الفئات التي كانت تلعب الشطرنج كانت على عداوة مع الأمويين، فهل كان الخليفة مروان بن محمد يرى فيها نواد للاجتماع وعقد الاتفاقات للثورة على حكمه وعلى السلالة الأموية واستبدالها بالعباسية.
صار ماء وردك بولًا:
كان أبو بكر الصولي من الأدباء الكبار، لكنه كان لا عب شطرنج لا يشق له غبار حتى أصبح مضربًا للمثل فيقال: فلان يلعب كالصولي. وقد أخبر المسعودي بأن الخليفة العباسي المكتفي كان من المتحزّبين للماوردي في الشطرنج، وهو صاحب التصانيف الكثيرة في الفقه الشافعي وقد جاءه لقب الماوردي لأن أسرته كانت تشتغل بصناعة وبيع ماء الورد. وحدث أن سمع الخليفة عن مهارة الصولي في الشطرنج، فدبّر لقاء بين الصولي والماوردي وقد دهش الصولي للانحياز السافر للخليفة نحو الماوردي في اللعب، لكنّ الماوردي لم يثبت أمام حنكة ومهارة الصولي في لعب الشطرنج، فلقد غلبه غلبًا لا يرد عليه شيئًا. وهنا تبيّن للخليفة حسن لعب الصولي، فعدل بهواه عن الماوردي وقال له: صار ماء وردك بولًا.
ويحكي المسعودي بأنّ الخليفة الراضي كان يتنزّه في روضة من رياض بغداد، فقال لمن معه من الندماء: هل رأيتم أحسن من هذا؟ فتبارى الأصدقاء في الثناء على زهر هذا الروض، فرد عليهم الخليفة الراضي: لعب الصولي بالشطرنج، والله، أحسن من الزهر الذي تصفون.
حبّ شطرنجي:
هو الحبّ كرّ وفرّ، ومنع ووصل، وهجوم ودفاع، واشتباك لا فكاك منه إلا بالخسارة والربح سواء بسواء على رقعة الشطرنج. هو الشطرنج خطوات محسوبة وغير محسوبة على رقعة القلب. فإذا كانت الحبيبة لا تلين بالغزل والمداعبات، إلّا أنها شغوفة بالنزال، فلماذا لا يلاعبها امرؤ القيس بالشطرنج: ولاعَبتُها الشِّطرَنج خَيلى تَرَادَفَت ورُخّى عَليها دارَ بِالشاهِ بالعَجَل
هذه الأبيات من قصيدة: تَعَلَّقَ قَلبي طَفلَةً عَرَبِيَّةً، فبعد شدّ وجذب بين امرئ القيس وتلك الفاتنة ، فرشا بينهما رقعة الشطرنج وتراهنا، فإن نال امرؤ القيس من ملكها فاز بقبلة. وعلى ما يبدو أن تلك الفاتنة تجيد اللعب والمكر، فتقول لامرئ القيس: فَقَالَت ومَا هَذا شَطَارَة لَاعِبٍ ولكِن قَتلَ الشَّاهِ بالفِيلِ هُو الأَجَل. فيستجيب امرؤ القيس للمنتصرة المتقنِّعة بالخسارة: فَنَاصَبتُها مَنصُوبَ بِالفِيلِ عَاجِل مِنَ اثنَينِ في تِسعٍ بِسُرعٍ فَلَم أَمَل وقَد كانَ لَعبي كُلَّ دَستٍ بِقُبلَةٍ أُقَبِّلُ ثَغراً كَالهِلَالِ إِذَا أَفَل.
وكعادة امرئ القيس في افتضاض مفازات الشعر للشعراء من بعده، فحذوا حذوه، فأصبح الشطرنج نديم جلسات العشاق، لا هو بالعذول ولا بالشخص الثالث، بل كان بينهما كالضمير منفصل متصل. هذا النديم الجديد انتشر في العصر العباسي، فأصبح مطلبًا في كل صديق أو جارية. وفي الإمتاع والمؤانسة يبين لنا التوحيدي بعضًا من صفات النديم بأنه يجب أن يكون قوي الدست – حسن اللعب – في الشطرنج. أدخل امرؤ القيس الشطرنج كاستعارة شعرية وإيروسية، حيث نجد قصيدة الزعفراني في زمن عضد الدولة البويهي تمور بالتشبيهات والرموز الإيروتيكية، ظاهرها أحجار شطرنج وباطنها للبيب فيها إشارة: غصبتني عليه خودٌ وقالتْ أنا من قد عرفتَ واسمي ظلوم وانثنت بي إلى مجال فسيح تدمن الركض فيه زنج وروم فأحاطا بشاهنا في مضيق ضاق ذرعا بمثله المكظوم فتخفّت من الحياء وغطّتْ ورد خدِّ كأنه ملطوم ثم قالت خذ الفؤاد سليمًا إن حبس المرهون عار ولوم.
وذُكر في كتاب، أنموذج القتال في نقل العوال، للتلمساني، بأنّه وجد في أمتعة أبي نواس بعد وفاته شطرنج، وهو القائل: تلاعبت بالشطرنج مع من أحبّه فنادمني حتى سكرت من الوجد وأنشدني مالي أراك مفكرًا تدور على الشامات وهي على خدي. وفي البيت الأخير تورية شعرية لطيفة فالشامات قد قصد بها أبو نواس الكلمة المشهورة التي يعلن بها موت ملك الخصم: شاه مات، فما بين الشاه مات والشامات على الخدّ حار الفكر وأناب.
ولأن الشطرنج لعبة حرب وحب ومنادمة، فلا بد أن يحضر في ألف ليلة وليلة. ولا بد أن تمثّل لنفسها شهرزاد بالجارية تودد، فهل افتهم شهريار؟ فتقص له حكاية الجارية تودد التي هزمت الشعراء ورجال الدين وأصحاب المنطق، فقال لها الرشيد: يا تودد بقي عليك شيء مما وعدت به وهو الشطرنج. وأمر الرشيد أن يحضر أسياد اللعبة، فهزمتهم تودد شرّ هزيمة، وكأنّ شهرزاد بعد هذه القصة تقول لشهريار، سيكون حالك حال من لاعبتهم الجارية تودد وهزمنهم!
أصحاب النرد وأصحاب الشطرنج :
عرف العرب النرد والشطرنج، ونسبوا النرد إلى الملك الفارسي أزدشير بأنه مخترع لعبة النرد، كذلك أرجعوا الشطرنج إلى الهنود. وقد فتنوا بهما ومثّلوا بالنرد والشطرنج مذاهبهم الفكرية، فيقول المسعودي في مروج الذهب ومعادن الجوهر، بأن بعض أهل النظر من المسلمين رأوا بأنّ واضع الشطرنج كان عدليّا، مستطيعًا فيما يفعل، أي أنّ الإنسان هو سيد أفعاله، وليست مقدّرة عليه. في حين صاحب النرد قدري مجبر، لأنّه في لعب النرد ليس له من خيار إلّا ما يوجبه النرد عليه من حظوظ الأقدار أو مساوئها. ونرى هذا التفريق بين الشطرنج والنرد، أي بين القدريين وأصحاب الإرادة الحرّة، فيما ذكره ابن تيمية، كما جاء في كتاب الغيث المسجم: اللعب بالنرد خير من اللعب بالشطرنج، لأن صاحبه يعترف بالقضاء والقدر. وقد جاء في كتاب محاضرات الأدباء ما يؤكّد هذا التوجّه: إنّ صاحب الشطرنج معتزلي، وصاحب النرد قدري على مذهب الأشاعرة. ومع ذلك فهناك حديث عن الرسول الكريم في موطأ مالك، بأنّ من لعب بالنرد، كأنّه صبغ يده بدم الخنزير ولحمه. فهل كان الرسول مع قول أينشتاين بأن الله لا يلعب النرد، ومع قولنا بأن الله يلعب الشطرنج!
باسم سليمان
خاص رصيف22

December 2, 2022
ساعي بريد خليل حاوي يأتي برسائل لم نعرفها- مقالي في رصيف22 – باسم سليمان
تندرج هذه المادة ضمن ملف الرسائل (
أمّا بعد
)، في قسم ثقافة، رصيف22.
يُحكى أنّ فاتك الأسدي نوى أن يقتل المتنبي بعد قصيدته التي هجا فيها ابن أخت فاتك، والتي قال فيها: ما أَنصَفَ القَومُ ضَبَّه/وَأُمّهُ الطُرطُبَّه. وحدث أنّ المتنبي كان عائداً من شيراز في قافلة له، فخرج عليه فاتك مع جماعة له، ودارت رحى معركة بين المجموعتين، وعندما أحسّ المتنبي بالغلبة لفاتك، أراد الهرب، فاستوقفه غلام له، وذكّره بأنّ الناس ستصفه بالجبن لو هرب، وخاصة أنّه القائل: الخيل والليل والبيداء تعرفني/والسيف والرّمح والقرطاس والقلم.
وهنا أدرك المتنبي مدى ارتباط الكلمة بقائلها، فعاد إلى المعركة وقاتل حتى قُتل. لم يكن تصرّف المتنبي عبثيّاً، فدوماً ما كانت تعتبر الكلمة امتداداً لصاحبها. أمّا نظرية رولان بارت عن موت المؤلف، وأنّ النصّ مستقلٌّ يحيا حيواته الخاصة بعيداً عن منشِئه، تظل تنظيراً وإنْ كانت تريد تحرير المبدِع من تبعات نصّه، حاصرة اهتمامها بالنصّ وحده.
لا ريب أنّ النقد النفسي للعمل الأدبي والفنّي سيجد له مكاناً في أيّ نظرية أدبية وفنية، فالبحث عن جوهر الإبداع، وكيف يتشكّل عند الشاعر أو الروائي أو الفنّان سيظل ملتحماً بذاتية المبدِع. وكثيراً ما اعتبرت سيرة حياة المبدِع والظروف التي عاشها، الظاهرة أو الباطنة، من مسببات الإبداع الحاسمة لديه، فكان البحث في ثنيات هذه الحياة الخاصة للمبدِع، من شواغل النقّاد الدائمة والقرّاء أيضاً.
فعل التلصّص الذي يقوم به المبدِعون تجاه الوجود، يقابله، في الوقت نفسه، تلصّصٌ من النقّاد والقرّاء نحوه. وتعتبر السيّر التي يكتبها الأدباء منهلاً مهماً لكشف هذه الحياة، وخاصة إذا كانت تتضمّن اعترافات حقيقية، كما فعل جان جاك روسو، حيث لا يجمّل المبدِع ذاته أمام قارئه، ولهذا أهمية كبيرة في فهم آليات الإبداع. تلعب الرسائل والأحاديث التي يتبادلها المبدعون مع عوائلهم أو أصدقائهم أو المعجبين بهم أو حبيباتهم دوراً حاسماً في الكشف عن الحياة السرّية لهم، فلقد شغلوا الناس بإبداعاتهم، فليس عجيباً أن يشغلوهم أيضاً بحيواتهم السرّية.
ولادة ثانية!عرف الغرب مبكراً أهمية هذه الرسائل، حتى أنّها شكلت جانباً مهماً في ساحة الأدب، ومن ثم اتبعناهم في هذا الاهتمام، فمن رسائل مي زيادة وجبران، إلى رسائل غادة السمان وغسان كنفاني وغيرهم الكثير، تطالعنا رسائل الشاعر خليل حاوي إلى القاصّة ديزي الأمير، والتي صدرت في كتاب عن دار النضال عام 1987.
تتجلّى قيمة هذه الرسائل في كونها تكشف بشكل عميق الحياةَ العاطفية للشاعر الذي انتحر في حزيران/يونيو من عام 1982، احتجاجاً على الاحتلال الإسرائيلي للبنان، فقد وجد على شرفته صبيحة السادس من حزيران/يونيو وبقربه بارودة صيد، ليضع حدّاً في النهاية لحياته التي أصبح يبغضها. يقول في إحدى رسائله إلى ديزي الأمير متأسفاً لها عن الضعف الذي استوطن فيه: “لا تحسبي أنّ الرجال كلّهم مثلي. كلا، هناك متّزِنون معتدّون أقوياء، وقد كنتُ في ما مضى واحداً منهم. وإنّي أحاول جهدي الآن لأعود إلى ما كنتُه في الأمس، وسوف أعود. سوف أغدو موضع تقديرك، بعد أن كنتُ موضع عطفكِ وإشفاقكِ، ويا بؤسه حب ينمو على هاتين الآفتين”.
يعود تاريخ هذه الرسائل إلى ما بين عامي 1955 و1962، وقد كتبت بين لبنان وبريطانيا، حيث كان خليل يعدّ دكتوراه في الأدب العربي في جامعة كامبردج، وقد رافقته ديزي في بعض أيامه في بريطانيا، لكنّها عادت بعد أن انتهت خطوبتهما.
تكشف هذه الرسائل عن الصراع الوجودي الذي يحياه الشاعر، فمن ناحية اعتبر ديزي “اليقين الوحيد الذي تثبت عليه حياتي”، لكنّه يقول في رسالة ثانية: “ما عدتُ أصلح للحياة المسؤولة، حياة الزوج والبيت والعائلة”. وبين هذا وذاك يقول في رسالة أخرى: “فكرتُ أنْ ألحق بكِ… فكرت وفكرت، ولكنّي بقيتُ في مكاني، لم أتحرّك، كنتُ على يقين أنّ أيّة حركة، مهما كان شأنها، ستخرجني عن حدود المعقول، لم يكن بإمكاني أنْ أميز المعقول من غير المعقول، فاعتصمت في مكاني، واستسلمت إلى الوجوم، وجوم أقسى من الحجر”.
ثم يتابع في الرسالة ذاتها: “كانت بي شهوة إلى البكاء، كنت أودّ أن أنظم أكثر القصائد حزناً. أتراني كنت أشعر أنّي فقدتك إلى الأبد، أم إنّك لم تكوني لي، ولم أمتلكك حتى في أعمق الساعات صدقاً وألفة؟”.
كان حاوي يرى في ديزي الأمير “ولادة ثانية له”، فقد كرّر هذه الجملة عدّة مرّات في رسائله وهي تشتبك مع رغبته أن يعود قويّاً، ولكن لن يتم ذلك إلّا عبر ديزي. وما بين هذه التناقضات تبرز جملته: “أنا أدري أنّي لست أهلاً لكِ”، لكنّه يعود ليبرّر عودته إليها: “لا تسألي لماذا، لماذا زحفتُ إليكِ في ما بعد. ولماذا تمسكتُ بكِ بإظافري وأعصابي وقلبي. كنتُ أطلب النجاة وكنتُ أكافح من أجلها، كنت أودّ أن أحيا ثانية، أن أولد ثانية وكنتُ بلا معين، وحدي أقاسي ألمَ المخاض. ألم من تتمخّض ولا تلد”.
وبعد كل هذه الاعترافات يرى الشاعر نفسه متكبراً، فيخاطب العشيقة متأسفاً عن حماقاته: “وندمتُ، ندمتُ كثيراً، كيف لم أترك نفسي على سجيتها وكيف لم أرسل إليكِ بكل ما كتبتُ، ويا ضياع ما كتبتُ ومزّقتُ، وكتبتُ ومزقتُ، لقد غلبتني الكبرياء الكاذبة، فأردتُ أنْ أتشبّه بكِ، أنْ أكون غير ما عرفتني في ساعات الضعف والهوان”.
هذه المختارات من الرسائل التي يبلغ تعدادها 31 رسالة، تُظهر مدى تشظّي نفسية الشاعر وتقلّبها، حتّى أنّه في بعضها يحيل إلى ثرثرات النساء في بيروت، بأنّها قد كانت أحد أسباب فشل العلاقة مع القاصّة ديزي الأمير. وفي أخرى يذهب إلى أنّ التزامه الشعري، بأنّه كان السبب: “وأنا أعلم ما أريد وما يبرّر وجودي وتحمّلي لشقاء الوجود، الشعر وحده”.
إلى الطليعة المقبلةقبل أنْ نحكم على الشاعر خليل حاوي، لنطّلع على بعض ما جاء في رسائله إلى إحدى طالباته في الجامعة ما بين عامي 1956 و1959 ، وهي ذات الفترة التي ولدت فيها رسائله إلى عشيقته ديزي الأمير، حيث نجد شخصية أخرى للشاعر ترتدي قناع دكتور الجامعة صاحب النصيحة الكاشفة والعميقة. صدرت هذه الرسائل عن دار نلسن عام 2013 بعنوان: رسائل خليل حاوي إلى نازلي حماده. تقول عنه تلميذته نازلي: “خليل حاوي كما عرفته إنسان رائع بكلّ معنى الكلمة، مزاجي بامتياز، واثق بنفسه، ناقد لاذع، ينفعل للخطأ ويدافع عن الحقّ. إنّه قمّة الشعور وذروة الإحساس والعطاء”.
تكشف رسائل حاوي اهتمامه بقضايا وطنه ومدى حرصه على مستقبل الشباب، حيث أهدى ديوانه الأول “نهر الرماد”، إليهم، عندما اجتمع بهم بمقهى “الصرفد” في “ضهور الشوير”، كاتباً على الصفحة الأولى من الديوان: “إلى الطليعة المقبلة”، وكأنّه بذلك يعني مقطعاً من قصيدته نشيد الجسر: “يعبرون الجسر في الصبح خفافاً/أضلعي امتدت لهم جسراً وطيدْ/من كهوف الشرق ومستنقع الشرق/إلى الشرق الجديد/أضلُعي امتدت لهم جسراً وطيدْ”. عندما نقرأ رسائله إلى نازلي حمادة نلقى شخصية أخرى متّزنة قوية رؤيوية تنفذ إلى جوهر الأمور، فنجده يخاطب نازلي:
“كم كنت بحاجة إلى رسالة مثل رسالتكِ تدلّ على أنّ في لبنان نفوساً طيبةً كريمة تستطيع أن تعاني المأساة دون أن تثور فيها عاطفة الحقد”. ثم يعلّق على طلب نازلي بأنْ لا يعود إلى لبنان، فيجيبها: “وكيف لي أنْ لا أعود وإنّي من الذين وقفوا النفس، ووطدوا النيّة على التضحية في سبيل الأجيال المقبلة”.
يتابع حاوي إخبار تلميذته بأنّه أحرق أوراقه، ولم يترك في لبنان إلّا الأشياء التي لها قيمة طيبة، ويقارن بين التقدّم والنظام الذي ألفهما في بلاد الغربة والفوضى في لبنان، لكن مع ذلك يحنّ إلى الحياة في لبنان، ففيها الحياة الحقّة التي يفتقدها في غربته.
كانت تلميذته تكتب بعض الخواطر والأشعار، فتبثه هواجسها، وهنا يخبرها أنْ لا تقلق من انقطاع الوحي: “لا تخشي من انقطاع الوحي، ولا تيأسي من عودته، إذا جفاك أحياناً، فإنْ من لا يجفوه الوحي، ولا يعصاه القلم دجّال يكذب على نفسه، فيكتب في كل حين، بلا وحي، وبلا حرمة القلم”.
وفي رسالة أخرى يخبر نازلي تعليقاً على المقال الذي كتبه نسيم نصر، أحد أساتذة الشاعر في مدرسة الشويفات في مجلة الأديب خالطاً التقدير بالتعريض، بعد أن قرأ في رسالتها رأيها في ديوان نهر الرماد: “خليل حاوي يصور مأساتنا، حقيقة مجتمعنا، يصور أفكارنا، أنفسنا، شعره نحن ونحن شعره”. وبناء على ذلك يقول حاوي لنازلي: “ماعدت أبالي، هل فهم أستاذي أم لم يفهم، ولا عبرة في أن يعلن أنّه معي، ومع المجدّدين في صراعنا ضد الجمود والتقليد”.
هذه هي ثورية حاوي الذي جدّد بها الشعر العربي ورأى بتلامذته جزءاً من الطليعة التي ستعبر جسر الشرق القديم إلى الشرق الجديد. ويتابع كما قال جبران يوماً: “لكم لبنانكم ولي لبناني”، بالقول: “لبنان في الذكرى أحبّ وأطيب من لبنان في الواقع. لبنان الذكرى… يعيش فيه تلامذتي وأهلي …أمّا لبنان في الواقع غالبية سكانه لصوص وبغايا، ملك كميل شمعون وسامي الصلح… غير أنّي انتهيت بعد مدّة إلى ذكر المليح في لبنان ونسيان القبيح”.
تتعدّد الجوانب التي يناقشها حاوي في رسائله إلى تلميذته نازلي حيث يخلط السياسي بالاجتماعي بالديني بالحرّيات بالطقس، مقارناً بشكل شعوري ولا شعوري بين المجتمع اللبناني والبريطاني، وكيف سمح لهم بالتظاهر ضدّ حكومة إيدن البريطانية التي اشتركت بالعدوان الثلاثي على مصر. ويعلّق على الحرية التي نالتها النساء مبدياً أسفه لِما انتهت إليه هذه الحريات من تهتّك.
ويذكر لها في إحدى الرسائل تلخيصاً لمسرحية لبرنارد شو التي يرد فيها ما معناه، بأنّ الفنان لا يستطيع أن يعبد ربّين؛ فنّه وامرأته! فهل كان يغمز من قناة علاقته بديزي الأمير وما انتهت إليه؟ وإنّ معظم الفنانين اختاروا الربّ الأول ورضوا لحياتهم البرد والوحشة. ويتابع الحديث عن مسرحية أخرى تعرض حياة ممثلة وصراعها بين فنّها والحب. يظهر الشاعر خليل حاوي في رسائله لنازلي حماده متّزناً مدركاً للواقع ومآلاته، فما الذي حدث حتى انتهت حياته تلك النهاية المأساوية؟
ولد خليل لعائلة بسيطة في ضهور الشوير عام 1919 كما يقول صديقه جهاد فاضل في مجلة “القبس” الكويتية. كان أبوه يعمل في البناء، وهكذا انتقلت العائلة معه إلى بلدة بوارج.
كان خليل متعلقاً بأخته أوليفيا التي نالت منها الحمى وماتت، ولأجل أنْ لا يشاهد الطفل خليل موتَ أخته، أرسلته العائلة بعيداً إلى أحد أقربائهم. وعندما كان يسأل خليل عن أخته كانت العائلة تخبره بأنّها في مدرسة داخلية. في هذه الأجواء نما الفقد لدى خليل وأدّت وفاة الوالد لأن يصبح خليل المعيل الوحيد للعائلة.
هكذا تدرّج في أعمال كثيرة وعلّم نفسه بنفسه اللغات والتحق بالجامعة، لكنّه كما يذكر جهاد فاضل عن خليل، لم يستطع نسيان أخته، فقد كان سؤاله المتكرّر عن أخته دليلاً على حجم الفقد الذي يعانيه: “غريب أمر هذه الطفلة! ما زلت الى اليوم أترقّب عودتها وهي لا تأتي. أين انت يا أوليفيا؟”.
لم تكن علاقة خليل بالمرأة مستقرّة، فهي تكاد تكون استمراراً للفقد الذي عاشه مع وفاة أخته أوليفيا. وعندما تعرّف على ديزي الأمير ظنّ أنّه قد صالح الزمن بها، لكن ديزي كانت امرأة متطلّبة كما يذكر فاضل، فهي تقول: “إنّ خليل ليس عصرياً… فهو لا يعتني بهندامه، ولا يشتري ألبسة جديدة. وهو لا يريد أن يغيّر أثاث شقته عندما يتزوج. فقد قال لها بأنّ الاهتمام بالأثاث لا يجوز أن يسري عليه. فالأغنياء هم الذين يهتمون بأثاث البيوت، وهو ليس غنياً. لذلك عليها أن تقبل به زوجاً وتتكل على الله”.
هذا التعليل الظاهري لا يتفق مع نفسية الشاعر الداخلية، فقد كان خليل قلقاً كئيباً، وما قوله إلّا رأس جبل الجليد الذي كان يخفيه في دواخله، فهل كانت ديزي تدرك ما يعانيه خليل؟ في المقلب الآخر تأتي الرسائل التي أرسلها لنازلي حمادة لتكشف حجم الصراع الوجودي الذي كان يعيشه حاوي، بين أن يكون شاعراً حرّاً لا يحدّه قيد، أو أن يتزوّج ويسكن للحياة العائلية.
بالتنبه لبعض الجمل التي وردت في رسائله إلى ديزي يكشف مقدار تخبّطه، فهو تارة يقول لها: “أريدكِ أن تستمري بالشوق والحب. أريدك أنْ تقومي بمعجزة: أنْ تحبّي رجلاً يتهدّم وأن تسعدي بحب ليس فيه غير الشقاء. إذا كنتِ مستعدّة على بيع الحياة من أجل سنة أو شهر من الحب الذي وصفته، فأنا مستعدٌ للتنازل عن كبرياء الرجال وأن أستجدي منكِ حبّاً، أنا على يقين أنّي لا أستحقه”.
وفي رسالة أخرى يقول لها: “اكتبي عن الحب عن النشوة عن الذكرى، اكتبي ذلك وافعلي في لبنان ما شئت، أحبّي، تزوجي، اسكري، عربدي، ولكن أكذبي عليّ وأنا مستعد أن أصدق. إنّي أمرّ بأزمة هائلة. أزمة تجعلني أتعلّق بحبال الوهم، فهلّا أبقيت على هذه الحبال ولو إلى حين”.
هذا التناقض كان مخيفاً لأنثى كديزي الأمير الهاربة مع عائلتها من العراق لتقع في براثن الحرب الأهلية اللبنانية. فليس غريباً أن لا يكون خليل مصدر طمأنينة لها. يذكر جهاد فاضل رأي ديزي بخليل الذي يكشف مقدار قلقها من رجل غير قادر على حفر خندق أمان لها في زمن صعب: “طباعه سيئة ومزاجه لا يحتمل، وهو يشرب الخمرة، وعشرته لا تطاق أحياناً لفرط سلبيته”. هكذا انتهت علاقة خليل حاوي بديزي الأمير، وتزوجت بعده، وتطلّقت، وقد حاول خليل أن يجد أنثى أخرى، لكنّ الزمان كان قد فات حتى يرتجل علاقة حبّ جديدة.
كان خليل يلتقي بديزي في شوارع بيروت ويتوسّل إليها أن تعود إليه، لكنّها كانت ترفض، وغداة الاحتلال الإسرائيلي للبنان غادرت ديزي الأمير بيروت. فهل كانت مغادرتها أحد أسباب انتحاره؟ مادام انتحاره قد جاء عشية دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي صيدا متوجهاً إلى بيروت.
يذكر أصدقاؤه بأنّه قد كان لخليل عدّة محاولات سابقة للانتحار، ولكنها لم تنجح، فهل كان يتنبأ عندما كتب في إحدى رسائله إلى ديزي عن مصيره ومصير بلاده، لذلك طلب منها: “أن تحبّ رجلاً يتهدّم”. كتب خليل إلى ديزي مستبصراً ما سيؤول إليه لبنان، ولقد لمّح إلى ذات الأمر في رسائله إلى نازلي حمادة: “في نفسي أثر لأحلام طيبة، كانت تراودني قبل الأزمة وقبل أن أدرك الواقع المرّ في العالم العربي، أمّا في الواقع، كما يبدو لي، فهو أنّي قد أستيقظ في أي صباح لأقرأ في الصحف أن لبنان قد تبخّر، قد حذف من الخارطة وأن أهلي لاجئون، أو أنّهم قتلى منطرحون على التراب في الشوير أو في طريقهم للتشرد الأبدي”.
تثور أسئلة كثيرة، بعد أن طالعنا رسائل خليل حاوي الكاشفة عن الصراع المرير الذي دار في خلده ما بين التزامه كشاعر بالكلمة حتى النهاية، أكانت كلمة حبّ، أو كلمة وطن، وبين ما يفرضه الواقع من أقدار. لقد خسر كلمة الحب مع ديزي، وعندما دخل الاحتلال الإسرائيلي إلى لبنان أيقن أنّه قد خسر كلمة الوطن، وقبلًا كان قد خانه الشعر في ديوانه الأخير، من جحيم الكوميديا عام 1979، فقد كانت الأصداء النقدية عنه سيئة، والآن، أصبح سيد الفقد الذي بدأ بأخته أوليفيا ولم ينته بديزي الأمير، بل تعداه إلى الشعر وإلى الوطن، فاستل رصاصة الرحمة، وأنهى حياته.
https://raseef22.net/article/1090753-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%AE%D9%D9%8A%D9-%D8%AD%D8%A7%D9%D9%8A-%D9%8A%D8%A3%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9-%D9%D9-%D9%D8%B9%D8%B1%D9%D9%D8%A7 https://raseef22.net/article/1090753-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%AE%D9%D9%8A%D9-%D8%AD%D8%A7%D9%D9%8A-%D9%8A%D8%A3%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9-%D9%D9-%D9%D8%B9%D8%B1%D9%D9%D8%A7

باسم سليمان's Blog
- باسم سليمان's profile
- 24 followers





