عبـــــــدالله خلــــــــيفة's Blog: https://isaalbuflasablog.wordpress.com , page 59
August 25, 2022
د. زهير ياسين شليبه : قراءة في رواية “الأقلف” للبحريني عبدالله خليفة .
 د. زهير ياسين شليبه
د. زهير ياسين شليبهالنغل نغل!
الشرق الشرق
قد يبدو لقارىء “الأقلف” أن مؤلفها البحريني عبدالله خليفة أراد ترسيخ هذه الدمغة الإجتماعية المتخلفة على خلق الله اللقطاء باعتبارهم بشرا من الدرجة العاشرة إلا أن الأمر ليس كذلك بالضبط فقد اراد الروائي إثبات العكس. فهذا يحيى الأقلف الذي تحمل الرواية صفته الأجتماعية لا إسمه يغدو في نهايتها حاملا هموم الناس يطارده تأنيب الضمير ويحملُ هموم الأمة على كتفيه.
ماهي جريمة هذا اللقيط الأقلف يحيى؟ ليس هناك اكثر من ان والده القادم من “غابات المحبة” غامر بحياته متجها نحو الصحراء ليلقح نخيل الشرق.
لكن مصيبة يحيى أنه بقي وحيدا في هذا العالم الصامت مع جدته الخرساء! لماذا هذه المصادفة؟ أهي صدفة ارادها الروائي ان تكون تحديا للشرق والأصالة والأسلام وبالتالي بلاده البحرين مكان الحدث الروائي؟
هل هي صدفة ان يخرج يحيى “كالنتوء” من بيئة هلامية، رمادية، غامضة مليئة بالقاذورات والحرمان والعدم وأن يكون كل هذا العالم المنسي المظلوم تحديا خطيرا للغرب الأستعماري وثقافته التبشيرية رغم تنصره وحمله الصليب؟
وهل هي صدفة أخرى أن يقف على طريق حياته الأليغوري لقيط آخر لا نعلم إن كان هو ايضا أغلف ام لا، ولكن لم يعد الأمر في هذه المرة يعني شيئا في السرد الروائي إذ إن هناك موضوعات أهم منها.
هل هو تأكيد على الأليغوريا الروائية والمغزى الفني لهذا العمل الذي تنبأ باصطدام الشرق بالغرب ام أنها رفض للمفاهيم الأجتماعية البالية والراسخة في اذهان الناس وتقسيم البشر إلى أصناف وانواع ودرجات إجتماعية؟
الجواب بالتأكيد: كِلا الأمرين فالروائي يضيف إلى هذين الهمّين هموما ومعاناة اخرى واراد ان يكرس روايته لها.
يحيى نتاج بيئته الصماء، كوخ ابكم يضم جدته الخرساء لكنه في حقيقة الأمر ليس اخرس حقيقيا بل مخرسا إن جاز التعبير، طفل مهمل لم يحصل على مستلزمات العيش والحنان الكامل.
فالقارىء لا يسمع يحيى يتكلم مع الآخرين إلا بعد لقائه مع زميله في “النغولة” إسحاق حيث يبدأ التعبير عما في خلجات النفس البشرية لدى هذين الكائنين البشريين ليتقاسما مشاعرهما ومعاناتهما من الأضطهاد والفقر والحرمان.
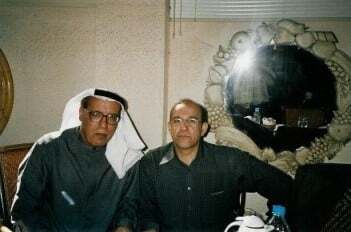 الكاتب الراحل عبدالله خليفه مع د. زهير شليبه
الكاتب الراحل عبدالله خليفه مع د. زهير شليبهإسحاق هو اللقيط الآخر، بطل الرواية الرئيس أو بالأحرى منافس يحيى في البطولة، بل إنه ينافسه في كل شيء بدءا من المعاناة الروحية والفقر والحرمان وانتهاءا بالبطولات والمغامرات والثبات والتحدي بغض النظر عن الأساليب والأهداف.
يشكل إسحاق التحدي الثاني الذي يقدمه الروائي في هذه الرواية، وهو النتاج الثاني الأكثر إيغالا في معرفة قسوة المكان ووحشيته. إنها في حقيقة الأمر جريمة يقترفها البشر يوميا، يحاول الروائي من خلالها وبزمكانيته الخاصة به أن يميط اللثام عن رياء المجتمع. ولابد من الإشارة بأنه لا يمكن الحديث هنا عن هذا الأغلف بدون عينه الثانية، إسحاق مرآته الحقيقية، التي يتمثل فيها التحدي الأكبر لعامة الناس “الأسوياء” والإحتلال البريطاني.
يقول هذا اللقيط إسحاق محدّثا زميله يحيى عن نفسه “وحين أنهارُ من التعب، ويسجنني المخزن في عفونته وظلمته وأغدو كيسا من أكياسه، تحرقني مشاعر غربة عنيفة وأصرخ: لماذا .. لماذا .. لماذا يعاملني أهلي بهذه القسوة … رحت أحدق في جلدي الغريب .. لم أكن إبنهم. وجدني الأب عند باب المسجد … صرت إبن حرام!” أنظر “الأقلف” ص 20.
إذن هما لقيطان يواجهان مقولة “النغل نغل”، التي يرددها الناس في كل مرة يستاؤون فيها منهما ص21 و هو التحذير الأكبر، الذي اراد عبد الله خليفه أن يقدمه للمجتمع المحلي والاحتلال البريطاني.
أليغوريا الشرق والغرب
[image error]غلاف رواية الأقلف 2002وإذا كان التلاقح غير المشرعن بين الغرب والشرق قد ولد يحيى بلا اعتراف أبعد “غرلته عن موس المسلمين” ص26 لترميه في عزلة على هامش المجتمع، تطارده زرقة عينيه دليل الهجينية المريب، فإن اللقاء الثاني بين هذين العالمين يتم في مستشفى الإرساليات حيث يلتقي بالممرضة ميري، التي تصبح حبيبته وشريكة حياته فيما بعد. وهو لقاء بين شخصين غير متكافئين، فالأول مريض، فقير، معدم، مهمّش، لقيط ومحروم من كل الحقوق الإنسانية، أما الثانية فهي ممرضة نصرانية غربية، تعمل في مستشفى الإرسالية الأميركية بعقد عمل يصون كامل حقوقها ويعطيها إمتيازات معروفة. يقول يحيى لميري “أبي ليس منهم. لوني وزرقة عينيّ تفضح إنتمائي إليكم. ثمة بحار أو طيار بذر في أمي بذرة ورحل … أنا لا انتمي إلى هذه المقابر الكالحة … أنا لا انتمي إلى هذا الخوص الكالح …”. ص85
وهي لغة تمثل بلا شك صوت الكاتب وليس الشخصية الروائية مما ابعدها كثيرا عن الطابع البوليفوني بسبب البون الشاسع بينها ومستواها الفكري والإجتماعي وهذا ما يؤكد أليغوريتها.
حتى التوسل بان على لسان رفيقه في الحرمان إسحاق “بجاه النبي مصطفى وسيدنا عيسى المسيح”. ص30
هل هي اليغوريا علاقة الشرق بالغرب؟ وقد يكون كل هذا الأمر ليس بالصدفة بل من وحي الكاتب واستلهاماته بحيث يبدو جليا في طريقة تفكير ميري وكأنها صياد يطارد فريسته بينما يقوم القس بتقديم الإرشادات لها.
تتميز هذه العلاقة الأليغورية أيضا بإستعلاء الطرف الأول المنقذ ميري على الجانب الآخر الذي تتجسد فيه مظاهر العصور الوسطى. تفكر ميري قائلة عن يحيى :” وقد تراه ذات يوم يجلد نفسه في الشوارع أو يجر إمرأته المحجبة بحبل!”. ص 39
فيقع يحيى فريسة بين مخالب التبشير بسبب حاجته للمساعدات الإنسانية في المستشفى ويبدأ بقراءة الإنجيل و”يندهشُ مدرّسُه اللبناني من التبتل الدراسي لهذا الشاب، ومداومته وحفظه السريع وأكله للمعرفة أكلاً، وتجاوزه لأقرانه السئمين من الكتب والحروف، وبمطالبه المعرفية المتزايدة، وضجره من البطء”. ص41
وهل هناك أسهل من استدراج هذا الأقلف المعاني من التهميش والحرمان والرفض حتى من عاهرة تبيع الهوى! “أنت نجس أيها الكافر غير المختن!”. ص69 إلا أن تنصّر يحيى يحمل أيضا أليغوريا شائعة في الشرق “الصبي الأخرس يريد أن يكون موظفا كبيرا، أو شرطيا قاسيا” ص 108، بعد أن يقرأ الإنجيل ُتمحى صفة الخرس عنه “إن الصبي الذي كان أخرس يغدو معلما”. ص 70
يدفع تطور الأحداث اللاحقة يحيى إلى إتخاذ موقفٍ آخر مغاير لحالته المستكينة وهو يعاني من الضغط والحرمان والفقر، فإن ظهور” شاحنات إنجليزية مليئة بالجنود الذين بدوا هادئين كالصخور وخوذاتهم وألبستهم البنية وبنادقهم المنتهية بحراب لامعة، بدت مخيفة، لكن الجمع المغبر الصارخ الكثيف سار كأنه يعرف بعض هؤلاء الضباط أيضا، كأنه التصق بهم في حفلات أعياد الميلاد البهيجة….”. ص 126
هذه المجابهة العسكرية بين الغرب والشرق حسمت الأمر بالنسبة ليحيى حيث يلتحق بالشعب ويساعد البحار المصوب برصاص الإنجليز مذكرا بموقف جان فلجان بطل “البؤساء”.
يُعتقل يحيى ويتم التحقيق معه من قبل ضابط إنجليزي. وعندها تبدأ حالة البوح عن المشاعر والمناجاتية والتعلق بعالم الصبا المتجسد برفيق العمر والشباب ودروبه فيما بعد إسحاق. أنظر الفصل 35 المكرس لعلاقته بإسحاق، الذي يودع في السجن.
لكن هناك غموضا حول تطور يحيى وتوظيفه محررا أو مترجما في صحيفة الإحتلال بعد أن أعتقل من قبل الإنجليز.
وهذا ما يلاحظه القارىء في الفصلين 36 و37 حيث تتميز اللغة بالغموض وكثرة الإنتقالات بين الوعي واللاوعي والحقيقة والخيال والحلم وتطور الأحداث.
ومقابل تجذر الصلة الروحية بينه والرمز الشعبي إسحاق، الذي أصبح له مريدون وحماية شعبية تنتهي علاقته بميري حيث يقول يحيى في هذه المرة: ” ليس لهم علاقة بالإله الذي ُصلب، إنهم حشد من الذئاب الضارية القادمة من وراء الصكوك والأسهم. ص 149
أي أن كل ماكان ينظر إليه نظرة سوداوية وإنتقادية في عالمه القديم أصبح اليوم طعمه أكثر حلاوة وأقرب إلى النفس.
ومن خلال العلاقات الهرونوتوبية تتجسد ثيمة اصطدام الحضارات والأديان والمصالح الإستعمارية وبالذات الشرق والغرب، الإسلام والنصرانية.
العلامة الأولى لهذه المواجهة الخطيرة يعبر عنها السائق الحاج سلمان بقوله موجها كلامه إلى يحيى: “كيف تغير دينك؟ هذا حرام”. ص 75
بينما يُجابَه يحيى برد فعل أعنف من قبل إسحاق نفسه، الذي يتهكم به قائلا:” أنت أغلف وهذه السكين ستحررك…”. ص 105
إلا أن هذه المواجهة تأخذ فيما بعد طابعا آخر يبدأ برد فعل يحيى نفسه الذي يضع يده على القضية ويكتشفها بنفسه وينظر إلى هؤلاء القادمين من الغابات الغربية نظرة شكوكية رغم أنه لا يزال على ديانتهم ومنتميا إليهم ويحمل الصليب في رقبته. ” كيف نزعم أننا مخلوقات الإله ثم نتقاتل على بقعة زيت وقطعة قماش …”. ص 128
ويكتشف فيما بعد حقيقة القس الأب تومبسون ” أهذا هو ذاته الراعي الطيب الذي ينتزع أورام الأجساد والأرواح والقطيع الهائج البائس إلى مملكة الرب؟ اين ذهبت ترانيم الأحد وصلوات الأعالي؟ بدا له انه خرف أو أصيب بلوثة مفاجئة …. “. ص 132
وفي مكان آخر من الرواية يشير الكاتب إلى هذه الأليغوريا ما بين النخيل والغابات على أنها علاقة الشرق بالغرب وأن إبنة يحيى عائشة تجسيد لهذا التلاقح تجمع هذين الطرفين المتضادين والمتصارعين منذ الأزل. ص 159
لكن هذه الطفلة الهجين عائشه لم تشفع لا لأبويها ولا للعالم كله كي تحل العقدة ويعم الوئام بين البشر، بل تغدو سلاحا بيد الغرب ضد الشرق حيث يهدده الضابط الإنجليزي قائلا ليحيى “سوف تدلنا على مخبأ إسحاق”. ص 16
وبهذا يضع الروائي بطله اللقيط البحريني، الهجين، المتنصر أمام اختبار ُيعد من أهم عناصر الرواية المعاصرة ليختار بين الانتماء إلى مكانه السفلي وبيئته بكل ما فيها من حرمان وقذارات وسفالات والتضحية بحياته وكل إمتيازاته مقابل إنقاذ حياة إسحاق وعدم الغدر به.
يفضل يحيى الخيار الأول فتفصل بينه وبين حياته رصاصة يطلقها الضابط الإنجليزي في راسه ليودع إبنته التي قد تستمر على دربه الأليغوري.
لم تكن عملية تنصر سهلة، بل مرت من خلال عدة مظاهر يتجسد فيها التخلف وإحتقار الإنسان مثل مقابر المسلمين الوسخة. “كانت مقبرة المسلمين الموحشة لا تستقبل سوى الفقراء والجنازات الكئيبة المتقشفة … اما مقبرتا اليهود والمسيحيين …. فكانت جنازاتها مختلفة، والبشر الحزانى يبدون بجمال غريب: بدلات سوداء وباقات زهور ونعوش خشبية جميلة فيظن ان القوم ذاهبون الى فرح صامت”.
ويقول في مكان آخر من الرواية : “وفي النهار تتفجر الصيحات من مآذن المساجد، ليندفع كورس جماعي يزلزل الفجر والنائمين، وتندفع بعده أصوات الحمير والكلاب والديوك والبشر، ويخرج أناس يقطعون اجسادهم ويضربونها…”أنظر ص 24، وص 46 وإنتقاده للختان وحالة المرض بسببه أنظر صفحات 51، 53
كمثال على ذلك يمكن ايضا الإشارة هنا إلى قصة العلاقة الخفية بين المعلم النصراني التبشيري نصيف البستاني والمرأة المحجبة من عائلة العنود التي ترتدي الملابس السوداء من راسها إلى أخمص قدميها. ص 87
هرونوتوب الرواية
يبدو المكان أبعد عن التوثيق، حاول الكاتب التمويه من خلال الإبتعاد قدر الإمكان عن ذكر أسماء الشوارع والمدن والمحلات وكأننا نعيش في مدينة ما في الشرق. لكنه يستعين بالهرونوتوب او الزمكانية للإشارة إلى مكان الحدث. فهنا كل شيء معلوم ومعروف بالنسبة للقارىء الواعي العارف والمطلع على تاريخ البحرين المعاصر.
نقرأ في الرواية: “وجد نفسه… ملحق بكوخ، وبأرض خلاء، وبسماء عالية … الأرض الخلاء الواسعة التي تلي الأكواخ، تبدو رمادية كالحة، تنتشر فيها الحفر الكبيرة التي تتخذ أمكنة لقضاء الحاجة، وهي تتحول إلى مستنقعات سبخة عندما ينهمر المطر. وتقع فيها مزابل واراضي رحبة مليئة برمل ناعم… وفي شرق هذه الأرض تقع أكواخ تمتليء بعبيد سابقين…”. ص 5
اما مدينة الأحداث فإن الروائي يشير إليها بدون ذكر إسمها من خلال وجود شركة النفط ولكن ماهي هذه البلدة مدينة النفط؟
أول مرة يذكر فيها الروائي شركة النفط في صفحة 44 “لكنك تعرفين أننا أخوات جئنا لمهمة مقدسة، وليس لإقامة صداقات مع مهندسي وموظفي شركة النفط”. ص44
ويقول ايضا عن مكان الحدث الروائي بطريقة غير مباشرة “إن البلدة تغرق في النوم والظلام … ذهبتا إلى مدينة النفط ذات البيوت الأوروبية …”. ص46
ومن الملاحظ أن الكاتب يبدأ بوصف المكان ثم يقدم شخصياته على أنها نتاج له: “رأينا في البستان المهجور مجموعة من الصبية. يدخنون ويسطون على الأعشاش، ويمارسون العادة السرية في الزوايا … أنظر هذا هو عالمك … مشيا ووصلا السوق. كانت هناك حشود من البشر المصطفة على جوانب الشوارع، تحدق في مسيرات دامية. … رجال أشباه عراة يضربون أجسادهم بالسيوف…”. ص 68
لكن الروائي يذكر إسم مدينة المنامه أول مرة في صفحة 76 حيث يقول : “قالت إن اسمها سارة، وهي يهودية! وابوها القادم من العراق أسس له تجارة مزدهرة في سوق المنامة”. ص 76
هناك بعض الغموض في مكان الحدث الروائي وزمانه في بعض الحالات ولا سيما في بداية السرد، لكن القارىء يلاحظ إشارة الروائي في نهاية الرواية إلى جسر يربط مدينة بأخرى “الشاحنة تعبر الجسر لتصل الى المدينة الأخرى…” ص 167
الوصف الخارجي للشخصيات
تظهر ملامح يحيى على دفعات: “كان شكله المميز، ولونه البرونزيين وعيناه الجميلتان، مدعاة لتحسسات لاذعة غامضة لجلده، وكانت ايديهم تتسلل وراءه …” ويقول في مكان آخر عن نفسه “ابي ليس منهم. لوني وزرقة عيوني تفضح إنتمائي إليكم”. ص 84
وتكاد الاوصاف الخارجية لملامح يحيى تقل إن لم نقل تختفي بعد هذه الصفحة. ويمكن القول بشكل عام إن الأوصاف الخارجية للأبطال تبدو غير تفصيلية وغالبا ما تشير إلى الحالة وتكرس كرمز لها.
الناستولجيا
يمكن اعتبار وفاة جدة يحيى بداية حالة الناستولجيا حيث طقوس الفاتحة والدِلال و”صلاة، يقف فيها كما يقفون” ص 121 “ويشتاق إلى أهل حيه، ذهب إلى أكواخهم ودكاكينهم ومجالسهم”. ص 122
تتوج ناستولجيا يحيى بحنينه إلى رفيق دربه إسحاق رغم شكوكه بأنه هو الذي حرق الكوخ وجدّتَه “هل يقوم بذلك حقا”. ص 122
لكنه “يود لو يكون قريبا من إسحاق” ويبقى مع ذلك متعلقا به لأنه أصبح رمز المقاومة. ص 125
وتتجسد ثيمة الناستولجيا ايضا بالبحث الدائم والدؤوب عن ملاذ آمن روحيا متمثل بإسحاق الرمز وذكريات الطفولة “سيذهب إلى إسحاق. سيسأله أن ينقذه من هذه الكتابة والرتابة… يندفع إلى الأزقة والمقاهي ويسأل عنه”. ص 146
مقابل تعمق ارتباط يحيى بعالمه القديم، نجد أن علاقته مع الجانب الآخر المتمثل بالكنيسة وزوجته ميري تتحول إلى منحى آخر يصل إلى القطيعة والعداء والتضاد في ضل اصطدام القوة الإستعمارية بالشعب.
نقرأ في الرواية: ” والآن هو في دورة المياه الفائضة، … ويرى وجه ميري المتعب يسال عن الأدوية ويصرخ في الشراشف القذرة، وهما يتعاركان فوق السطح بين الغسيل المتطاير والريح وضجة الطائرات العسكرية المدوية الهابطة”. ص 146
هل هي نهاية غير سعيدة لعلاقة حميمية بين الشرق والغرب؟ وهل يا ترى ستنتقم الطفلة الهجين عائشة لجريمة قتل والدها يحيى؟ أم أنها ستجرب رأب الصدع بين الشرق والغرب ودمجهما.
قد يفاجؤنا الروائي عبدالله خليفة بالإجابة على هذا السؤال الصعب في رواية جديدة تتناول جيل هذه البنت اليتيمة ومستقبلها في عالم أصبح قرية صغيرة في ظل العولمة.
[image error]August 24, 2022
طفوليةُ الكلمةِ الحارقة : عبدالله خليفة
 طفوليةُ الكلمةِ الحارقة
عبدالله خليفة
طفوليةُ الكلمةِ الحارقة
عبدالله خليفة
حين يهاجم مثقفٌ متنورٌ معتقدات الناس القديمة المتوارثة المتواصلة وهم في غياهب الظلمات غارقون في البؤس، ويضربُ مقدساتهم بسياط كلماته، لا يجني سوى الشقاء.
وهذه بطبيعة الحال ستكون شرارة. أما احترقتْ أجسادُ المتنورين في نهاية العصور الوسطى بنيران الكهنة؟ لكن حيواتهم الثمينة احترقتْ مع جلودهم وأدمغتهم والعطاء المأمول منهم.
أحمد القبانجي أو تركي الحمد بنقدهما لمقدسات الناس يتم اصطيادهما في السجن وتُهدد حياتهما.
الهجماتُ ضد المقدس التي تطال الرموز البشرية والاعتقادية جزئيةٌ، انفعالية، غيرُ مبنيةٍ على درس عميق وتحليل مديد.
هي التنويريةُ الطفولية، وحرقةُ مثقفِ التيارات الاجتماعيةِ الثقافية القلقة المعبرة عن الفئات الصغيرة ولعدمِ وجودِ الطبقات المنتجة الجماهيرية بثقافتِها المتأصلةِ الواسعة الانتشار، وهذه التنويريةُ الساطعةُ في لحظةٍ حادة كأنها انفجارُ نجمٍ، فهي تريدُ دهسَ الظلام دفعةً واحدة، كأن الظلامَ هو شخصٌ ماضوي، أو فهمٌ أعوج لحادثةٍ، مركزيةٍ في الذهن الشعبي السحري، وهذه التنويريةُ الفردية الشجاعة والطفولية كذلك تَحدث في العالم العربي الإسلامي بشكل مستمر وهو يعيدُ إنتاجَ الشموليات والتخلف على مدى قرون.
ولكنه كذلك يشكلُ تجديداً ويراكم طبقات صغيرة من التحولات.
لهذا نجد التنويري مثل لحظة طه حسين أو أحمد القبانجي أو تركي الحمد، ذا صلة هشة بالطبقة الوسطى مشروع النهضة الاجتماعي، حيث نجدُ هذه الطبقة في اللحظة التاريخية المعينة أجساماً صغيرة مُفتتةً، تركزُ على دكاكينها ووكالات تجارتها، وإيجاد مقاولات وأعمال لدى ملاك الزراعة الكبار والحكومات.
فلا تجد هذه الفئات أي صلة بين نقد الشعر الجاهلي ومشروع النهضة والتحرر من الاستعمار وقيام الدولة الوطنية.
وكان انفجارُ طه حسين جاء في جُملٍ صغيرة تسخرُ من تاريخ ديني، في حين أن الكتاب ليس ذا صلة وثيقة بهذه الجُمل التي حُذفت في الطبعات التالية ولكن الكتاب حرك سلسلةً طويلة من البحوث في تاريخ العرب.
الناس الذين ينتقد المتنور تصوراتهم الدينية السحرية ُ يعيشون في عالم ذي أسس موضوعية تكرس العلاقات غير السببية، فالفلاحون يحرثون الأرض بمحاريث تقودها الثيران، والتجار مشدودون لمخازنهم يكدسون البضائع يريدون بيعها بأعلى سعر ويستغلون المشترين ما أمكن ويتهربون من الآلات والمصانع إلى بناء العمارات السهلة الربح.
وإذا جاء القليلُ النادر منهم للمتنور في جامعته أو كتابه أو برنامجه الفضائي سيغضبون من جمله الناقدة لتراثهم الديني المقدس.
إن كل ما كتبه وحرق عمره من أجله لم يصل لهؤلاء الناس، فراح يسلطُ عليهم نيرانَ عباراتهِ من أجل أن يحركهم ويستثيرهم ولكنه جرحهم وبلبلهم.
وما يكتبهُ من آراء تنويرية مثالية لا تصل لتحليل العلاقات الموضوعية التي يعيشون فيها، ولو كان كذلك ما صفعهم بجُملهِ، فهو يسخر من رموز يقدسونها، لا يجدون بينها وبين مشكلاتهم علاقة. وهو يتصور أنه بقلقلةِ وجود هذه الرموز يتمكن من تغييرهم وهدايتهم للتقدم المنشود.
إن هذه الفئات الوسطى الصغيرة غير قادرة على تجميع رؤوس أموالها الصغيرة لبناء المصانع الحديثة، التي تُخرج الناس من المزارع الصغيرة ومن الحِرف ومن الجثوم في المقاهي، وعبر هذه التحولات تظهر ظروفٌ جديدة لهم، للثقافة، ولمحو الأمية، والارتباط بالأجهزة التقنية المتطورة، وإنتاج أجيال من المتعلمين المختلفين، حيث يحدث هنا تراكمٌ للمعرفة الجماهيرية العلمية، وحيث يبدأ الناس بفهم الحياة والمجتمع بأشكال موضوعية.
لهذا نجدُ أن لحظةَ طه حسين تم تجاوزها مصرياً حيث حدثت تطوراتٌ كبيرة ولكنها لم تكتمل بعد، في حين أن أحمد القبانجي العراقي لاتزال بلاده غير قادرة على خلق مثل تلك التطورات المركبة ولم يتواجد الحضن الجماهيري الديمقراطي الحديث الواسع. في مصر تُطرح مسألة فصل السياسة عن المذاهب بقوة الآن من أجل التركيز على برامج التحول الاقتصادي الشعبي، وهو البرنامج الذي يرسخُ أكثر بنيةَ المصانع وبنية الحداثة والمعرفة العلمية، فيما تغدو تصورات الإنسان الدينية من حريته ومن حقه.
ولكن إضاءةَ المتنور المغامرة تُستخدم من قبل القوى المتطرفة دينياً في تكريس التخلف والقمع، فهي تقتنص الخطأَ الإجرائي في عرض المعرفة التي لم تأتِ في سياقها الديمقراطي الجماهيري الحديث فتجعلها جريمة.
هكذا كان أصحابُ المغامراتِ اللادينية في العصور الوسطى يهاجمون المعتادَ الشعبي من الدين دون قدرة على تغيير وعي الناس، لأن هذا الوعي مرتبط بظروفِ إنتاجهم ومعاشهم وتقاليدهم وحياتهم الشخصية، فيذهب المتنور ضحية الفخاخ التي يصنعها المحافظون وضحية مستوى المعرفة المحدود في الناس.
August 15, 2022
الانتهازية الفكرية : عبـــــــدالله خلــــــــيفة
 الانتهازية الفكرية
الانتهازية الفكريةإن انتشار الانتهازية الفكرية بين المثقفين العرب بشكل واسع يطرح أسباب هذا الخراب الاجتماعية والسياسية، فلماذا هذا الحول الفكري الكبير ؟ ولماذا يتم ابصار جهة معينة فقط من الطريق، وترك جوانب أخرى متعددة في هذا الطريق والتي تؤدي بالسائر إلى الإصدام وإلى السير في زقاق مسدود في أحيانٍ كثيرة؟
لماذا لا تتشكل الموضوعية التي ترى الأسود والأبيض، وتبصر مجموعة السلبيات والإيجابيات؟ لقد قلنا مراراً حول قوانين تشكل الفئات الوسطى وعلاقاتها بالقوى المسيطرة، وكيف تتذبذب حسب مصالحها، ولكن لا بد الآن من الدخول إلى الآليات النفسية التي تكوّن الأنماط الرئيسية من المثقفين المخادعين والتي تجعل الكذاب يتصور نفسه محقاً، وإلى اعتقادات المنافق بأنه بطل، وإلى البهلوان الذي يتصور نفسه بأنه يخدع الجميع ويقبض من الجميع دون أن يلاحظه أحد؟ هناك تصور ساذج لدى المثقفين بأنهم أذكياء جداً وأن أحداً لا يعرف ألاعيبهم، وأن الشعب هو كومة من الناس الأغبياء، دون أن يدرك أن ثمة حساسية خاصة، ووعي غائر تاريخي يتكون في هؤلاء البسطاء، ويشكل معرفة تاريخية أكثر عمقاً وبقاءً من هلاميته وبالونات اللغة التي يطلقها في الفضاء، معتقداً بأنه يشكل ألعاباً سحرية لا أحد يستطيع أن يبزه فيها! تقوم عقلية المثقفين الانتهازية على مقولة خدمة الأنا المطلقة، باعتبارها هي المحور في كونه الضيق، فكل القضايا والتحولات والمشكلات سوف يراها من خلال مصلحته الشخصية، وسيغير كل الحقائق الموضوعية الصلدة في الحياة، لكي يفصّلها على مقاس مصلحته، ومن هنا فكل المقاييس الأخلاقية سوف تضيع في هذه الحالة، وستغدو الشاشة الفكرية التي يفترض أن تبحث عن الحقيقة، تائهة ومائعة، وستتآكل القيم الإيجابية في النفس من شجاعة ونزاهة وأمانة، وتحل صفات أخرى مذمومة من نفاق ورياء، وهي الصفات التي تقود المرء للهلاك الأخلاقي. والفرق هنا بين كتلة الشعب الغامضة تلك، وكتلة هذه النمطية من المثقفين، هي أن كتلة الناس لا تحتاج في أحكامها وقراءتها البطيئة المحدودة والمبعثرة إلى مجاملة أصحاب السلطان، ولهذا تكون وهي في بيوتها وحرفها البسيطة، منتجة للموضوعية الفكرية التي عجز المثقفون الانتهازيون عن إنتاجها. حين تظلل المثقفين المصلحية فإن أحكامهم عن الحقيقة وعن الأخلاق تتبدل، ويقومون بطرح معايير فاسدة، كالقول بأن الشعب مجموعات غوغائية لا يمكن الوثوق بأحكامها، وأنه لا توجد معايير للحقيقة، وأن كل شيء نسبي، وأن المعرفة خادعة، أي أنهم يطرحون كل الأفكار التي تحاول ترميم ضمائرهم المنخورة بالفساد، وبالمصلحية. ولهذا تتعرض الأحكام الفكرية والمناهج النقدية والآداب والأفكار والفلسفات التي ينتجها هذا النمط من المثقفين إلى التلون بمظلات الدول والقوى المهيمنة والمصالح السائدة. إن ثمة نظارات توزع على هذا النمط من المثقفين لكي يروا العالم من خلال زجاجها الخاص، فهم يرون المذابح كأنها عرس نضالي، و الحارات الكثيفة بالفقر باعتبارها دليل على جهل الشعب وحيوانية الإنسان الخ..! إن هذه النظارات ذات الزجاج الخاص سوف تتغير إذا تم إعطاؤهم نظارات جديدة من قبل مورد جديد لديه فيض مالي ووظائف، وحينئذٍ سوف تتغير المعايير وتتبدل الرؤى ويرون ما لم يروه سابقاً. ولكون اللسان ليس فيه عظم ولا ضمير عند هؤلاء، فإن الكلام يتبع المصلحة الشخصية، ويتمدد ويتقلص كالطين اللزج حسب المناخ وزجاج النظارات. أما أن الناس ليسوا معياراً أبدياً للحقيقة فهذا صحيح، ولكن الناس يراكمون المعرفة الموضوعية عبر عقود طويلة، ولهذا ينفرز المثقفون في وعيهم، فثمة كلمات تغوص وتتشربها أعماقهم وثمة كلمات تتبخر في الهواء. والناس ليسوا كائناً خرافياً فيه الصواب المطلق ولا الخطأ الأبدي، ولكنهم الأرض التي تستقبل البذور، وتشكل من الرموز الحقيقية المضحية أشجاراً، ومن الانتهازيين الثقافيين أشباحاً وارواحاً شريرة وعفاريت خطرة!
الانتهازية الفكرية
بائع الموسيقى : عبـــــــدالله خلــــــــيفة
 بائع الموسيقى
بائع الموسيقى قصـــــــةٌ قصـــــــــيرةٌ
ــ 1 ــ
جاءته الضجة من السقف عنيفة حادة . راح الأطفال يلعبون الكرة على ملعب رأسه. الجدران تهتز ، والصرخات تتسرب من الشقوق ، والضحك يصير نزيفاً في جلده.
يتطلع إلى دفتر النوتة و أسلاكه الشائكة لا تمتلئ بطيور الموسيقى . يتصاعد الصراخ في الأعلى ، و تترنح القشور الصفراء من السقف نحوه. ثمة خطوط داكنة كثيفة على الجدار ، كأنها ثعابين نائمة في الرمال.
تنزل أصابعه بقوة على البيانو . شلال من الشرر يتبعثر من الفضاء نحو الشجر. تتصاعد آهات غريبة حادة وعنيفة وسط الصياح وضجة السيارات والكراجات. أصابعه تجري على المكعبات البيضاء الشفافة عصافيرٌ ممزقة لا تكف عن الزقزقة ، و النزيف ، و التحليق ، و إرتجافات تتصاعد ، وكبوات تنزلق إلى قعر الأرض.
تنفجر الضجة فوق ، وبدا أن شجاراً أندلع بين الصغار. هناك رفس عظيم على البلاط و العظام. أخذت خريطة كبيرة من القشرة تهتز، و حدث تبعج في كرة السوائل الكريهة في روح الجدار.
توقف.فتح النافذة بعنف.أطل لاوياً عنقه إلى الأعلى. كانت السماء محاصرة بين عمارتين. أسياخ تمتد هنا ، تركها ، تركها العمال نازفة بالأسمنت والماء ، و مكيفات تهدر هناك تبول وتفح على الطرق و الرؤوس. و زرقة السماء لم يرها أبداً. عباءات من الرماد والغبار والأوكسجين الغائب ولعاب النار. يصرخ ، و يصرخ ، دون أن تفتح النوافذ ، أو تخفت الضجة ، أو يتوقف العويل ، أو يسلم الصغار رأسه له ، يدقون بأحذيتهم على قشرة دماغه. تتساقط أصابعه في الهواء.
يضع شيئاً فوق جسده ، و يتوجه نحو باب الشقة . كانت صالته معتمة ، فارغة من الأشياء و الكلام ، يصعد إلى الطابق الأعلى ، يرى غابة من النعل و الأحذية و الصنادل . مدينة باكستانية كاملة تجمعت فوق روحه شاكية سلاحها ، ناثرة روائح الدهن و عطن الأسرة و الثياب المبلولة.
يضغط الجرس بشدة. يطلع شرطي نزع نصف رداءه ، ويحدق فيه مستاءً. ليس ثمة لغة بينهما ، و يظهر و راءه ذلك الحشد المخيف من الصغار ، ونسوة ذوات أجساد ضخمة.
يشير إلى الأطفال ، الذين بدوا حلوين رائعين في هياكلهم المزهرة بالضحك و الورد ، يدق على رأسه ، و يشير إلى أوراقه و بيانوه و غرفته والجدار المتشقق..
ينزل والضجة خفتت قليلاً ، والأحذية المهترئة الكثيفة، والرطوبة المشتعلة ، و الهدوء المراوغ ، و عفاريت الشقة ، و البيانو البارد ، طردت أنامل الروح..
ــ 2 ــ
ــ يا عزيزي ، يا سمير ، دعني أؤلف و كف عن هذا الضجيج النحاسي!
هذا ما كان يقوله لشقيقه ورفيق شقته ، رئته الأخرى التي نزحت من صدره ، والذي جاء به إلى هذا الحبس الانفرادي ، و تركه وحيداً لقشور السقف المتساقطة ونيران الأرض الشاملة.
تعاونا و اقتسما الشقة ، وودع سمير بيتهوفن وباخ وموزارت ، وزعق مع الآلات الموسيقية المُعلبة ، و صراخ الحديد ، و راح يذبح الطيور التي زقزقت في سدرة عمره ، و يسهر طوال الليل في العلب التي يحمحم فيها بآلاته ، و المكبرات الضخمة تهز المكان الصغير ، والعيون الكثيفة تحدق في الراقصات ، و سحابات الدخان تغسل الجلود و الثياب بالكربون.
ــ سمير ماذا فعلت بنفسك، أخي حبيبي كل هذا السهر..والمجيء في الفجر، توصل البغايا إلى شققهن ، ثم تنام إلى الظهيرة وتسعل وتبصق طوال الليل .. ثم لا تملك ثمن التبغ و تستولي على علبي و خبزي !
يرد ساخراً :
ــ أهذه عيشة نحياها؟ إلى متى تهدر مواهبك لدى باخ .. ماذا تجدي مثل هذه الموسيقى العنيفة ، الحالمة ، الساحرة..وسط هؤلاء الأجلاف ، التيوس القادمة إلى حظيرتنا من كل حدب وصوب ؟
يمضي حاملاً طبلته الضخمة ، و يعسكر في البار ، و يدق ، و يعزف ، و ينتشي بطوق ورد بلاستيكي ، ناعم مثل الوزغ ، ملوث بالبصاق والسل ، وكل يوم يتمنى أن يغني أمام هؤلاء السكارى الشبقين ، و في الفواصل ، بين رقص النسوة ، في لحظات تعبهن ، وتجفيفهن للعرق واللعاب ، يُعطى الفرصة ليغني أغان لا تطالع سوى المقاعد الفارغة و العلب المهروسة . يغرد في بيت الراحة ، وينزف ذكرياته و أظافره ، و ليس ثمة صدى أو هوى ، ويعود إليه في غبة الليالي ، والفجر رمز لدم مجهول في السماء ، وينبطح على الفراش مسلماً إياه قطعاً من رئته..
يرمق البيانو مرعوباً :
أعزفْ ! أعزفْ ! علك تغدو فداءً للمسنين في الدخان و الظلمات. أعزفْ! ربما تتوقف الشقوق في الأبدان ، و ينام الأطفال في حجرك مهدهدين بالأحلام. أعزفْ و أسلخ عظامك و أغرزها في الرمال الصفراء الزاحفة على الأرصفة. أعزف واحضن أخاك المتساقط على الدرج ، و أنت تتلمس دمه ، و لامبالاته ، أعزفْ في هذا العرق الكامل ، ضع علاماتك النادرة الشاحبة بين هذه الأسلاك و الأفلاك ، وجوهاً من الجميلات اللاتي أحببتهن ، وهربن من يديك إلى البيوت الكبيرة والقصور والحانات ، أعزفْ وجيبك فاضٍ وروحك فائضة !
ــ 3 ــ
ــ يا أخي كريم ، ألم تشبع بعد من هذا الجوع كله ، سرير بارد ، وعش معتم ، و ثلاجة تحتفي بالصراصير ، و حي مليء بالأغراب و الدخان و الزحام و الأنقاض..؟! تعال ، طالع ما أنا فيه الآن: شقة واسعة قرب البحر ، وصديقة جميلة ، وما لذ وطاب !
يرمقه برثاء .البدلة و الهاتف النقال و السيارة لم تملأ شقوق هيكله الخاوي. يخاف أن تكسره الرياح والزجاجات والسجائر والسهر.
يضيف :
ــ وجدت لك عملاً مناسباً. عزفٌ راق في مطعم ومشرب محترم. تستطيع أن تتلاعب بالبيانو أمام أولئك العشاق ، ستجد ثللا من العصافير والكناري تسجد لك..
كانت الشقة فارغة ، لم يبق إلا البيانو و كرسيٌ صغير رفيق بها.أخذت أجراس المالك ، و الباعة الذين تسلف منهم ، و الأصدقاء الذين نسي ديونهم ، تصير أوركسترا الألم اليومي.
تأمل روحه في المساء وهي تنزلق إلى الحمى :
في عتمة النور المقطوع راح يصرخ : لماذا تعزف على ضؤ شمعة ، ولماذا تعصر جسدك لينزف؟ أكتفِ بكل هذه الألحان الميتة في التابوت ، والغرق في بركة الأصوات ، كفى ! كفى ! عُدْ إلى أهلك ، انزل إلى الحظيرة ، كفاك جرياً
وراء هذا الباص الفضائي !
يترنحُ ، يلوحُ مهّدداً لخصمه الرابض في الظلام ، تغوص أصابعه في تنور الموسيقى ، تصرخ عروقه و هي تسير إلى الحمم ، ممتلئة بالانفجارات ، و تتطايرُ كتلٌ من النار و البحر في الجليد الشعبي ، فيطير فوق مستنقعات الضفادع ، ثم يترنح متألماً ، جائعاً ، يعبُ من الهواء الساخن الرطب ، شبه عارٍ ، مغسولاً بالعرق..
نظرات الجيران الأجانب تحدق فيه بدهشة و هم يصعدون إلى شققهم ويفتحون الأنوار والمكيفات.
ذهب إلى المطعم والمشرب عازفاً ، فوجده محاطاً بحديقة جميلة ، وبدت القاعة واسعة وأنيقة ، وجثمت البيانو بعيداً عن البار و الحضور ، معطية خطواتها الملائكية مساحة شعرية ، فراح يدندن بأحلامه و بأغنيات العشاق الكبار وبجراحه..
في بضع الليالي القليلة تلك ، حلق و أعاد النور و الكلام للشقة ، والطعام والنوم لجسده ، و كوّن إلتماعات لمقطوعات راحت تتشظى بين عزف المساء ونزف الظهيرة ، وسعد برفقة مطربة شابة أجرت حنجرتها طوال الليل للسهارى..
ثم فوجئ في ليالي العطل بزحف مخيف : حشود ملأت القاعة، و غترٌ كأنها موج من الأعشاب الدامية . ضحكوا من رقرقة البيانو . ضجوا من عشق النوارس . ذبحوا البجع و أكلوها . و استراحوا حين و ضعوا شريطاً ملوناً تحت خصر المغنية الراقصة..
كان يتطلع إلى ذلك الحشد ذي الأفواه المفتوحة ، الذي يلتهم العلب والمكسرات و الدخان ، يضع أشرطة من المال على أعناق الراقصات ، وينهض متعاركاً وشاتماً ومدعياً وباكياً ، يقرقر بمياه الشيشة ، يترنح في دورات المياه، وينسى أحشاءه ورؤوسه وجيوبه في الغرف ، وكرامته في الشوارع..
أعزفْ للسكارى ، و أنس الكونشرتو ، و سيمفونية المزامير ، و رقص البجع في البحيرة الذهبية ، و أرتعب من هذه الأيدي الفظة تنقض على الصدور البضة ، وأفراس الشهوات تحمحم وتنثر النقود تلالاً من القصور تنمو بين الأثداء ، و للخزائن و هي تنفض تحت أقدام العاهرات ، و أنت تسقط بين الأزقة و القشور و الحضور و الخصور و الأنقاض ، تترنح ، والليالي تدور ، و لا فضة أمطرت ، و تعود للشقة كل فجر تحمل ضجيج الطبول ، و أيدي الدخان ، و ثلل من المارة لا تتكلم إلا تحت نافذتك ، و السيارات لا تتعطل بطارياتها إلا عند وسادتك ، و العمارة لم تكتمل والمسامير تغرز في عقلك ، فأعزف دمك !
ــ 4 ــ
ماذا يريد الليل أن يقول ؟ لماذا يمدد جسمه كالأرغول ولا يقول؟ لماذا ينمو كالغول ولا ينبس؟
يجلس على مقعده وراء الآلة. السحارة المعدنية التي تفيض بالثعابين. يدق بأصابعه على أسنانها فتتقيأ الموسيقى والأرداف والتأوهات وتظهر النسوة يهززن أثداءهن الملأى بالورق ، و تنفتخ السماعات الضخمة بانفجارات الهواء. هنا تقوم الدببة بالغناء. هنا تغازل أفراس البحر القمر.
شقته امتلأت بالأثاث ، وعظامه باللحم ، وآذانه بالصمم ، وقلبه بالحصى ، وصدره بخرائط الفحم !
يرى أخاه متخشباً على فراشه. ظهر جلادٌ دمويٌ في رئته ، انتزع نصف هيكله ، و راح يبكي كلما التهم ضلعاً ، حتى تسلمه أخيراً جريدة من نخلة يابسة.
يمشي على البلاط البارد للمستشفى . يقاد إلى الأجزاء الأخيرة لأخيه ، ذلك الخوص الباقي من الفضة.
هوذا يعود إلى الشقة. ليس ثمة سوى البيانو على تلة من نور. أحجارها تتكلم وسط الخرس:
آهة تتصاعد من الشرق . ثقب أسود هائل يبتلع الورق والوجوه. آهة خافتة تتسرب من الأرض. يجثم على البيانو.
أصابعه تتلمس جسد حبيبته. ينزل أخاه إلى قعر الأرض. تتبرعم أصوات وأغصان. تأوهات خافتة لمقتولين في المدن. أصابعه تدق بخفوت . والروح المحبوسة تتقلقل في المياه. آهة حادة تتصاعد من الشرق . هو يمشي متسولاً تحت النوافذ . السقف ينهمر مسحوقاً خانقاً. تنفجر الموسيقى بغتة: ضرباتٌ عنيفة تتصاعد ، مطرٌ يهطلُ ، عواصف تضرب الأرصفة ، أضواءٌ غريبة تندلع.
خفوتٌ عميقٌ في الشرق . آهاتٌ خفيضة . زقزقة عصافير أخيرة قبل الرصاص. الأيدي المدهوسة لا تزال ترتعش . ضربات ملتاعة ، معذبة ، راكضة في شتى الجهات . السقف يتقلقل. صمتٌ مريع ، صمتٌ خائن ، ومطر الدم والنور يتدفق بلا أفق ، ينهمر السقف بالأشلاء .
لاتزال أصابعه تتحسس البياض.
تكويناتُ الطبقةِ العاملةِ البحرينية : عبـــــــدالله خلــــــــيفة
 تكويناتُ الطبقةِ العاملةِ البحرينية
تكويناتُ الطبقةِ العاملةِ البحرينية عبرتْ الأشكالُ النقابية البحرينية عن انقسامٍ عميق في الشعب والقوى المنتجة عامة، فالانقسامُ السياسي الطائفي عكس نفسه على التكوينين النقابيين، ولمحدودية حضور البحرينيين في الانتاج المادي (26%) من العمل العام للسكان المواطنين والأجانب، وجسَّد كذلك صغر حجم الانتاج الرأسمالي الكبير الخاص والعام وضخامة الانتاج الصغير وهي نفس السمة التي تمثلُ أسلوب الإنتاج العربي ذا المواد الخام الرئيسية المُحاطة بشبكةٍ من المؤسسات التجارية والمالية والسياسية الاستنزافية له، وأعطى هذا الجسمُ الاقتصادي تكويناتٍ نقابيةً محدودةً ضعيفة العضوية وشبابية بالدرجة الأولى وبحرينية لا تضم العدد الكبير من العمال الأجانب والأجيال القديمة من العمال البحرينيين أنفسهم.
ضعفُ هذه التكوينات النقابية لا يعود فقط إلى انقسامها بل أيضاً لطبيعة الجسم الاقتصادي الاجتماعي، من حيث قلة عدد الشركات والمصانع الكبرى، وكونها كما قلنا لانتاجِ وتحويل المواد الخام: النفط، والألمنيوم، والحديد المستورد، وإعادة تصديرها، مما يجعل جسم الطبقة العاملة لا يعتمد على التكوينات البشرية الكبيرة، وهذا التكوين الاقتصادي للبلد لا يقوي البناءَ الصناعي العلمي للسكان، فالشركاتُ الصغيرة الكثيرة العمال المتناثرين، تعتمدُ كذلك على غالبيةٍ عمالية أجنبية، ووراءهم أيضاً ما يُسمى بحثالة البروليتاريا، أي عمال كثيرون هامشيون، هاربون، أو باعة جوالون، أو عارضون لقوة عملهم في الشوارع!
طبيعةُ أسلوبِ إنتاجِ المواد الخام، لا يجعلُ الصناعةَ تضم القوى الرئيسية للسكان رجالاً ونساءً، وهذا الأسلوبُ الصناعي القديم يضعفُ الصناعةَ والتطور الاقتصادي عامة، وينعكسُ في الطبقة العاملة، المنتوج البشري لهذا الأسلوب، الذي يهدرُ الكثيرَ من الفوائض، ولا يقومُ بإعادتِها للبناء الاقتصادي لأجل تغييره وتحديثه بالصناعات الجماهيرية أو بالصناعات المتطورة التي تبدل نمط السكان الاقتصادي.
لهذا يغدو الهدرُ الاقتصادي وتوجه الفوائض المالية خارجَ الانتاج كما أن القسم الأكبر من الفوائض يعيدُ إنتاجَ نفسِ البنيةِ الاقتصادية المتخلفة ولشروطِ تجديدها في الإدارة والتعليم والصحة الخ.
ينعكس ذلك في تكويناتِ الطبقة العاملة، من حيث ضخامةِ القوى العاملة الأجنبية(مائتا ألف عامل وعاملة)، يعمل أغلبهم في مصانع المواد الخام أو في المهن الثانوية الكثيرة، وتذهب أغلبيةُ الأجور للخارج.
وتغدو التكويناتُ السياسيةُ والمالية والاقتصادية تعيدُ إنتاجَ هذا النمط وتوسعه بأشكالٍ غيرِ مخططةٍ وتلقائية حسب قوانين السوق العفوية.
هذا الأسلوبُ الانتاجي (القَدري) المعتمدُ على هباتِ الطبيعة المباشرة، وهو الشكلُ الأولي من الانتاج الرأسمالي العالمي، والذي يغدو تابعاً للأشكالِ الرأسمالية المتطورة في الغرب والشرق، يعتمدُ على هذه المواد الخام الثمينة ومراكز إنتاج الطاقة لكي يحصل على فوائض يبددُهَا في الاستهلاك، فيخلقُ عمالاً ذوي رؤى دينية، يعيشون هم كذلك على هبةِ الطبيعةِ المباشرة بدون تطوراتٍ علمية مهنية وفكرية وسياسية كبيرة في مهاراتهم العملية وفي أنشطتِهم السياسية والنقابية، ولهذا فإن العمال اليدويين أغلبية كاسحة.
ومن هنا هم ينقسمون نقابياً بحسب المذاهب الاسلامية المحافظة التي سيطرتْ على إنتاجها قوى الإقطاع القديمة، وينقسمون بحسب أديانهم في مجموعات العمال الأجانب القومية والدينية غير المنظمة نقابياً والمتجمعة بأشكالٍ جماهيرية خاصة.
كما أنهم ضعفاء لصغر أحجامِهم في المؤسسات الاقتصادية، الميكروسكوبية، مع قلة العمال المنظمين للنقابات، وغياب القاعدة الرئيسية من العمال، كذلك فإنهم يضعفون أنفسَهم بتبني الآراء الطائفية المحافظة المغرقة في الرجعية الفكرية، والانتهازية السياسية، ولهذا فإن توسع مثل هذه الجماعات النقابية يمثلُ مشكلةً وخطراً نظراً إلى نشر الانقسام والصراعات الطائفية وتغلغلها في الشركات وبين العمال والناس!
وكانت الطبقة العاملة سابقاً تلعبُ دوراً طليعياً في توجه المجتمع والشعب نحو الوحدة والتحرر والديمقراطية بسبب طبيعة الطلائع في ذلك الوقت، لكن الطائفيات السياسية لم تواجه الواقع بموضوعية، وتوجهت للصراع السياسي الفوضوي فأضعفتْ النقابات وشلتْ الوعي العقلاني والدارسَ لبُنية الطبقة العاملة وكيفية تطويرها، ولسبب قيادة الإقطاع الطائفي الذي وجهها للصراعات السياسية المغامرة فكانت النخبوية الصغيرة والانقسامات وعجز العمال عن رفع أجورهم حتى بدولار واحد!
إن الجسم الوطني من الطبقة العاملة هو الذي يلعب الدورين السياسي والنقابي، وسنجدُ تغيراتٍ كبيرةً في هذين الدورين خلال المرحلتين السابقتي الذكر: مرحلة الوطنية ومرحلة المناطقية العالمية.
لقد انقلبَ الواقعُ في الحياة الاقتصادية عنه في الحياتين السياسية والنقابية، فقد ساد العمالُ الأجانبُ في بُنية العمال وتحجم العمالُ الوطنيون.
كان العمال المسيسون الوطنيون والنقابيون البحرينيون في الشركات الكبرى قد مارسوا دورهم من خلال ذلك بالتناسق مع الحركة السياسية الوطنية الاجتماعية من خلال مطالبها المختلفة.
وهذا الواقع تعرضَ للتغيير مع تبدل البنية الاقتصادية، وفيضان العمال الأجانب.
يُلاحظ من خلال الإحصائيات تدفق العمال الأجانب نحو الخدمات الإنشائية، والأعمال الهامشية، وأعمال الملكيات الصغيرة الاسمية قانوناً، وقلة منها تتجه نحو الأعمال الإدارية الكبيرة، وهذه الفئة تنضم إلى القوى المالكة للمؤسسات الاقتصادية أكثر من ارتباطها بالعمال.
يوجهُ هذا التكوينُ العددي الكبير الواسعُ سهمَهُ الحاد في مجتمعٍ صغيرٍ على العمال اليدويين وذوي التعليم المحدود وغير ذوي الإمكانيات التقنية والعلمية، سواءً كانوا في المدينة أو القرية، لكن ما يجعل أكثرَ ضرباتهِ تتجهُ للعمالِ في الريف هو تماثلُ الشروط العملية بين العمال الأجانب والعمال الوطنيين الفقراء في القرى، واختلافها في الشروط الاجتماعية، فالمشرعُ يجلبُ عمالاً ريفيين ذوي أجور زهيدة جدا ويلقي بهم في سوقٍ ضيقةٍ مكتظةٍ وبشكل كثيف.
فوجدَ عمالُ القرى والأحياءِ الشعبية المدنية أنفسَهم يواجهون منافسين أشداءَ كثيرين، وبشروطٍ معيشيةٍ غير متساوية، فتغدو قوانين حساب قوة العمل الوطنية بشروط تجديد إنتاجها هنا غير شروط تجديد العمال الأجانب عيشاً وكلفة وفروق أسعار للعملات، بسبب تباين قيم المساكن وإعادة إنتاج العائلة معيشيا وتعليميا وغير هذا من متطلبات الحياة المختلفة بين البحرين والبلدان التي جاءَ منها العمالُ الأجانب، فمجيئهم من الأرياف والمناطق المهمشة في بلدانهم يجعل كلفتهم متدنية جدا، وردود أفعالهم على سوء المعيشة وفقد الحقوق ضعيفاً.
كما ان إسكان أغلبهم في المناطق الرثة، وحملهم الأمراض الجسمية، وغياب أي حس وطني أو حضاري في المناطق الجديدة التي سكنوا فيها وأغلبها في مدن البحرين العريقة في الحارات القديمة، يدمرُهم إنسانيا، ويجعل تجميع النقود لديهم بأي صورة عملية ملغية لطبيعتهم العمالية الكفاحية المفترضة، إضافة إلى سوء الطعام المقدم والمبيع إليهم من المطاعم الرخيصة السيئة المواد والطبخ، ورداءة المساكن التي يعيشون فيها بأشكال جماعية تعاونية، وغياب زوجات الأغلبية منهم، ان كل هذه الظروف أهلت الأغلبية الأجنبية من العمال لتلعب دورا سلبيا في تطور الحركة العمالية البحرينية، خاصة مع مجيء قيادات نقابية عمالية بحرينية ذات رؤى معينة.
ولقد ظهرت الحركةُ العماليةُ النقابية خلال العقد الأخير كنتاج ردود فعل لهذا الواقع الاقتصادي العمالي المتناقض، فثمة تدهور لمراكز تجمع العمال المواطنين، وغياب أي دور نضالي عمالي عام، وثمة كثرة للجزر العمالية المفصولة عن بعضها بعضا، وكثرة للعمال الموجودين خارج النقابات، إضافة إلى وجود الأغلبية العمالية الأجنبية جسماً موجوداً في البحرين ومؤثراً في اقتصادها وظروف معيشتها ولكنه خارج النقابات فعليا.
وليست مصادفة هذا التقابل بين قيادات نقابية دينية وجسم عمالي أجنبي معزول. لقد جاءت القيادات النقابية البحرينية ذات التفكير المذهبي كردِ فعلٍ على اقتحام العمال الأجانب الحياة البحرينية، مثلما دخل جمهور العمال الريفيين خاصة في تأييد كبير للحراك السياسي الديني.
ولهذا فقد واجهت الوجود العمالي الأجنبي الكثيف بشكل سلبي، فلعله يختفي بالتجاهل، وبالتالي فقد أضعفت من أوراق الطبقة العاملة في البحرين ككل، من حيث غياب درس هذا الوجود العمالي الأجنبي ورؤية مشكلاته وأوضاع بشره السيئة المنعكسة على البلد صحة وسكناً ومعيشةً ومصيراً عماليا.
إن الوعي الديني المحافظ انعكس في مشاعر كراهية الأجانب، وعدم إدخالهم في التكوينات النضالية المحلية، وبالتالي ضيع هذا أوراقاً مهمةً في النضال العمالي وفي التفاوضات وفي الصراع ضد الاستسهال في جلب العمال الأجانب ونشرهم في أي مكان وفي غياب حقوقهم وبجعلهم مادةً مؤثرةً ضد العمال البحرينيين.
August 6, 2022
الفكرة ونارها : عبـــــــدالله خلــــــــيفة
 الفكرة ونارها
الفكرة ونارها لا يمكنك أن تلغي الفكرة بالإجراء، بالموقف الإداري، أو حتى بالعصا!
الفكرة تقاومها فكرة، والكلمة تدحضها كلمة.
في العالم التقليدي الدينار يكبر الرؤوس والسياط تشل الألسنة، والكهوف تقوي الأبصار، ولهذا فإن جرجرة الصحف والكتاب للقضاء ومراكز الشرطة لن يفت في عضد الكلمة بل سيغمر أصحاب الدعاوى بالعار. الكلمة تنمو بالجدل، واحتكاك الكلمات وتصادم الأفكار يولد شرارات المعرفة.
ألا ترى صحفاً في العالم الشرقي المتكلس هي عبارة عن نشرة واحدة؟
ولم تحدث هذه الصحف عقلاً بل جهلاً وتصادماً وانهيارات؟
لقد تداخلت قوى التخلف والمحافظة خلال عقود لشل الكلمة وتحنيطها، وملء صفوفها بالمبتذل والسطحي، وبالتالي تجميد المجتمعات عن التطور.
مرت عقود منذ أن نشأت الصحافة البحرينية نشأة متفردة ترتقي إلى مستوى هام للصحافة العربية، فكانت سياسة وأدباً وتحقيقات عميقة وتشكيلاً لرموز ثقافية وطنية كبيرة كتاباً يصنعون كتباً في شتى الآداب والفنون لا معقوين بالكاد يفكون الخط.
ولهذا فقد ماتت كل الأفكار لأن الفكرة لا تستيقظ إلا بخلافها، والمطبوعة لا تتجلى بدون منافسها.
أما أن كل كلمة تستدعي ناطوراً، وكل مطبوعة تقف خلف سطورها كشافات الاستادات الرياضية فهي تغدو معوقة ونزيلة مستشفى عظام.
أما أن تتزايد القوى الأهلية التي تراقب الكلمة وتطاردها وتتفاقم تدخلاتها فهذا دليل على ضعف فكري لغوي سياسي، فلن يغير الفكرة الأجراء الإداري، أو الخطب العصماء في المؤسسات الأهلية الدينية التي كان ينبغي أن تنتج مثقفين ومبدعين ومتغلغلين في الثقافة العربية.
الفكرة شرارة تتغذى بالفكرة وتغدو ثقافة وعلوماً وحضارة، أما العصا فهي تصنع المستنقعات.
August 2, 2022
عبـــــــدالله خلــــــــيفة : سردية الانكسار والانتصار في رواية «التماثيل»
عبدالرحمن التمارة*
1ـــ «التماثيل» محتوى المحكي:
ترتبط أحداث رواية «التماثيل»‹1› للروائي عبدالله خليفة بمرجعية سردية اجتماعية، فتنبني على ما يمكن وصفه بسردية «الفضح والتعرية»، بوصفهما فعلين قادرين على كشف الخلل بين الفرقاء الاجتماعيين، خاصة إذا تعلق الأمر بالأصدقاء والأقرباء، ونظام العلاقات التي تربطهم.
هكذا تحكي الرواية عن المسار الحياتي المثير للسارد «حسان يوسف» وصديقه «ياسين كافود» الذي صار معروفا بـ«ياسين الفينيقي». إنه مسار أساسه المفارقة والتباين بين «الفينيقي» الذي لم «يكن ثمة شيء مبهر في عالمه»‹2›، وبين صديقه «حسان» على مستوى الوظيفة والطموح والقيم والوضع الاجتماعي والفكري. لقد توجه «ياسين» لدراسة الطب البيطري بالخارج، وصار «حسان» موظفا بقسم الأرشيف بالمحكمة بتدخل من رجل ذي نفوذ، فتمكن من دعم أسرته الفقيرة، ومن الاطلاع على ملفات الأرشيف، منها ملف يضم «حكاية علي البحراني وكيف جاء إلى الصحراء وأسس مملكة العيون وكيف تآمر عليه أتباعه الذين أعطاهم البساتين فقتلوه..»‹3›. غير أن الوظيفة بقسم الأرشيف بالمحكمة أشعرت «حسان» بأنه يعيش حياة الموتى والسجناء، وازداد إحساسه بالمأساة حينما عاد صديقه «ياسين» من الخارج وقد تغيّر كليا. وبعدما عاد «ياسين» إلى مهجره الدراسي بدأت تنشط المراسلة بينه وبين «حسان»، فأطلعه على «تاريخ الأرض منذ أن صنعها الشيخ علي البحراني»‹4›. لكن تلك الرسائل كانت وراء اعتقال «حسان» بتهمة «خيانة الأمانة»، بالرغم من أن «ياسين» ادّعى ادعاءات فكرية بحثية تؤكد اعتكافه على تقصي المعلومات النوعية التي لم يسبق نشرها.
بعدما فُصل «حسان» من وظيفته بالمحكمة اشتغل صحفيا يقوم بالتحقيقات، فتعرض مرة ثانية للاعتقال بسب اعتراف «ياسين» عليه بتزويده بأرشيف المحكمة. لهذا بدأت أزمته وانحداره الأخلاقي، لكنه التحق محاسبا بالبنك بوساطة من «نرجس» زوجة «ياسين»، فصار يمارس معها المحرّم إلى أن غدت حاملا منه، حينما كان «ياسين» في السجن، فاستفاد من معلومات «عبدالمحسن» التي دلته على الكنوز الدلمونية. إنها الكنوز (تماثيل، عقود، لؤلؤ دلمون المتحجر) التي رفعت «ياسين» إلى مَصاف الشخصيات البارزة، ودفعت بـ«حسان» إلى سراديب السجن مرة أخرى، بدعوى اختفاء خريطة مواقع الآثار الدلمونية. لهذا حين غادر «حسان» السجن استقبله «ياسين» بحفاوة، وبدأ مناورته من جديد كي يحصل على «خريطة الآثار» النفيسة المخبأة منذ عهد الدلمونيين العظام، فاهتدى إلى تزويجه ابنته «ندى» علَّها تنتزع منه الاعتراف بخرائط الكنوز (تماثيل، ذهب، آثار)، وقد تحقق ذلك بعدما اشتد تعذيب «حسان» من لدن جميع أفراد أسرة صديقه. بيد أن ما قام به «ياسين» سيصير تهمة ملفقة لـ«حسان»، كما أخبره ابنه «علي» من الزنى مع «نرجس»، بأنه «متهم بسرقة تماثيل بلد، وبيع ممنوعات، وتوزيع منشورات»‹5›.
تُتابع نجاحات «ياسين» على حساب إخفاقات «حسان»، لكن في لحظة إشراق نوعية يعود لحياة طبيعية، بعدما رُزق بطفلة من «ندى»، فكتب كتاب «لصوص القلعة» الذي لقي استحسانا من لدن القراء، لكنه كتاب دفع به إلى سراديب السجن مرة أخرى، بدعوى أن «الكتاب الذي أصدره المدعو حسان يوسف عن سرقة آثار قلعة الشمال هو بلا أدلة وتشهير غير مسؤول وغير مبرهن عليه»‹6›. وقد عانى «حسان» في سجنه المهانة والتعذيب، وحينما أُطلق سراحه وجد “العالم” من حوله قد تغيّر، لكنه عاد، بفعل الحاجَة المادية والمعنوية، إلى مساعدة «ياسين الفينيقي» الذي عينه رئيسا لتحرير جريدته الواقفة على حافة الإفلاس. غير أن ذلك لم يمنعه من التعرض لمكيدة جديدة، فبعدما رغب جملة من الشباب في الحصول على «الكنوز الدلمونية» اقتادوا «حسان» واحتجزوه كي يدلهم على خريطة المآثر، فاهتبل «ياسين» تلك الوضعية كي يضخ الأموال في رصيده البنكي، ويعلن أن «حسان يوسف» «أخذ أموال الإعلانات من العديد من الشركات والبنوك والمؤسسات الرسمية التي أعلنت في الجريدة خلال الفترة الماضية، ثم اختفى وهرب.. وتقدر الأموال المسروقة بحوالي مليون دينار»‹7›. وستزداد مأساة «حسان» حينما تفجرت المواجهة بين الشبان الذين يحتجزونه، وبين خصومهم الراغبين في الحصول على المآثر النفيسة، فألقي عليه القبض ووجهت إليه محكمة عسكرية تهمة الانضواء لجماعة إرهابية، إضافة إلى قضايا مدنية مختلفة: «سرقة أموال، وحيازة ثروة وطنية وإخفاؤها»‹8›.
يتضح أن النسق الجمالي والدلالي العام المؤطر لمحكي رواية «التماثيل» هو نسق (التوازي) (parallèle)، فتصير الوضعية الدينامية لشخصية «حسان يوسف» داخل الأحداث مقابلا ضديا للوضعية الدينامية لشخصية «ياسين الفينيقي». لذلك لا ينتج نسق التوازي النمو المتكامل للشخصيتين، بل نموا مفارقا لهما، فيتكرس الصراع بوصفه مبدأ جماليا ودلاليا يؤطر علاقات الشخصيات (خاصة ياسين وحسان)، ويفضي بها إلى الانتصار أو الانكسار، باعتبارهما مستويين يمثِّل كل واحد منهما كوْنا دلاليا مفتوحا على تنوع المدلولات.
يظهر أن رواية «التماثيل» لـ عبدالله خليفة تستدعي مقولتين رمزيتين متلازمتين جدليا، الأولى دالة على الانتصار، والثانية معبّرة عن الانكسار. لهذا سنبرز الدلالات الرمزية التي تنفتح عليها المقولتان السابقتان، والجماليات البانية لتلك الدلالات، انطلاقا من التأويل بوصفه (قراءة ماكرة ليست غايتها أن تفرض معنى محددا على النص بل تقترحه عليه)‹9› كما يلي:
2 ـــ «التماثيل» : مستوى الانتصار:
يتشكّل (الانتصار) داخل النص الروائي «التماثيل» عبر دينامية تخييلية أساسها جمالية (التعرية)، لأن الانتصار يضمر مشروعا رمزيا قادرا على تعرية المسكوت عنه في امتدادات الشخصية داخل محكي الرواية، سواء كانت أفعالا، أم مواقف، أم حالات.
من زاوية تصنيفية، واعتمادا على نسق التوازي، يمكن اعتبار شخصية «ياسين الفينيقي» هي المقترنة بمتخيل الانتصار. بيد أن انتصار تلك الشخصية يكرس واقعا مخترقا بالمآسي، ومؤطرا بانحدار قيمي وأخلاقي، وموجها بسلطة وعلاقات. لهذا يغدو الانتصار مفارقا لحقيقته الدالة على النمو التطوري للشخصية، فيصير الانتصار عنصرا رمزيا يعري زمنا يعمّه الانحلال والنمو الارتكاسي، وواقعا يحتضر ويتجه نحو موته الحتمي. لهذا يمكن بناء شبكة دلائلية متنوعة يفصح عنها تأويل مستويات الانتصار المضمرة، أو الدلالات المتضمنة والمحتملة داخل هذه المستويات، ومن أهمها:
■ انتصار (المثقف) المزيف: أو انحراف الكلمات والحروف
يقول «ياسين الفينيقي» متحدثا عن تجربته بالمهجر، وموجها الحديث لصديقه «حسان يوسف»: «هناك وراء الحجر والأسلاك الشائكة يوجدُ النورُ. لو أنك رفعتَ رأسك قليلاً لرأيتَ سحبَ العصافير التي تعبرُ للحقولِ الخضراء ، في هذا المدى وجدتُ الرسالة، سطورها من عزرا باوند وإليوت، هناك كلمتني الملائكة وقالت لي كونَّ سرباً من النوارس، أمحو هذا الرمادَ الشرقي وشواهدَ القبور والعباءات، هناك تعلمتُ الكيمياءَ ورأيتُ النساءَ حرات، في تلك الأزقةِ التحمتُ بوجوهِ الشعراء والكتابِ وأصبحتْ لرسالتي حروفٌ وكلمات . .»‹10›. إنه مقطع سردي يحمل رمزية التناقض الصارخ بين فضاء الوطن المسيّج بالقيود (الأسلاك) والثقيل بالإكراهات (الحجر)، وبين فضاء المهجر المنير (النور) المنتج للحرية، فتشتعل الذات المثقفة وتنبعث من رمادها و«أرضها الخراب»، وتتحرر من قبرها وتقاليدها البالية. وهذا يسمح للذات بأن تبني (المثقف الحقيقي) والحر، فيصير الكلام مسموحاً به، والتعبير لا خطوط تحده أو رقابة تمنعه. إن ذلك ينتج سببيا إبداعا وفكرا تؤطره جمالية التأثير، لأن المثقف له رسالة وغاية ومعنى، فيتجلى جزءا من نسق سوسيوثقافي يعطي أهمية للأدب والإنتاج الثقافي (رمزية الحروف والكلمات)، ويجعله أحد عناصر صناعة التوجيه وإصلاح الخلل.
وتفصح نبرة «ياسين الفينيقي» التوجيهية (هناك..) والانتقادية (لو أنك..) والتوصيفية لشكل الحياة في المهجر عن ولادة مثقف حقيقي، ستكون عودته للوطن منطلقا لتأسيس فعل ثقافي قوامه التغيير من جهة، وأساسه التعالي على التبعية لمؤسسات التدجين من جهة ثانية. بيد أن تطور أحداث الرواية أفصح عن ولادة (مثقف مزيف)، فكانت الانتصارات حليفه، لأنه دشن شهرته الثقافية بخذلان صديقه «حسان»، حينما اتخذ «الادعاء» آلية لتشييد صورة المثقف الباحث والنوعي المحب لوطنه والمنقّب عن تاريخه: «حين عدت لقراءة الجريدة المحلية فوجئت بحلقة يكتبها ياسين عن «الأرض الخراب».. كانت صفحاتي وشخبطاتي وأسطري نفسها مع مسحة تزويقية صغيرة هنا وهناك، وعناوين مبتكرة وادعاءات فكرية بحثية من قبيل (إن المؤلف عكفَ عدة سنوات على تقصي هذه المعلومات ورجع إلى مراجع كثيرة وغاص في بطون التاريخ، ولم ينشرها إلا بعد التأكد الدقيق منها)» ‹11›. إنها عفونة (المثقف) الذي يرسم شهرته الثقافية على جهود الآخرين، إنها الدلالة الرمزية لمجتمع منحط يقدم فيه الكثير من المثقفين دروسا في الانتهازية، فيبدو (المثقف) كائنا معرفيا ينتصر لثقافة البريق والشهرة، ويهندس مساره بسلطة الخديعة ومنطق الادعاء والتهافت.
وبهذا تضيء شخصية «ياسين الفينيقي» داخل رواية «التماثيل» عالما رمزيا معاصرا قوامه (المثقف) الحربائي؛ فهو أولا إنسان يمتهن الثقافة، مما يمكنه من حياة مريحة ماديا، ومن حركية دائمة فيزور المؤسسات الثقافية الكبرى، ويجني الجوائز المشبوهة، ويقترب من منابع السلطة. وهو ثانيا مثقف لا يبني مجده بالمعرفة والفكر، بل بالمال والثروة، أو بنظام العلاقات السلطوية. لذلك يخاف من ضياع مجده الثقافي إذا ضعفت علاقاته القوية، أو نضب مورده المالي المحرم (التماثيل المسروقة في الرواية). وبهذا يمثل «ياسين» نموذجا رمزيا للمثقف المزيّف الثري والسلطوي؛ حيث يتحدد وضعه الثقافي بثروته وعلاقاته، وليس بثورته والتصاقه بقضايا الجماهير وبوضعه الثقافي وإنتاجه المعرفي. لذلك يبدو «ياسين» خائفا على مكانته الثقافية، وما يستتبعها من مكانة اجتماعية ووضع اعتباري، حينما يعتزم «حسان» فضح امتلاكه «تماثيل» تراثية مسروقة، فيخاطب زوجته قائلا: «بعد هذه الحياة المرفهة والسفر وحضور الاحتفالات في السوربون واليونسكو والحصول على الجوائز الثقافية العالمية والأكل مع رؤساء الدول في مآدب واحدة، ندع هذا المراهق [حسان] يفسد كل شيء»‹12›.
يظهر أن «ياسين الفينيقي» لا يتحدد بثقافته، بل بوضعه المادي. لذلك يتراءى لنا هذا التصنيف (الثري – المثقف) بوصفه رمزا لفئات اجتماعية تنتصر لثقافة اليافطات الرمزية، لأن بعض الأثرياء، وليس الكل، يحاولون بطرق غير مشروعة تسويق صورة المثقف. وهذا يجعل (الثقافة) يافطة تبعد أو تؤجل إمكانية التساؤل عن أصول الثروة، بالنظر إلى الوضع الاعتباري والرمزي للمثقف اجتماعيا وأخلاقيا. غير أن هذه الصورة الذئبية للمثقف قد تظهر جلية في اعترافاته المحكومة بمجاراة السلطة، والخضوع لبريق المال وسلطة الجشع، والإذعان لقيم المكر والتحايل، يقول «حسان» في هذا المقطع السردي: «ياسين يرسل لي رسالة يستهزئ بوجودي كله:
ــ حصلت على قلادة وطنية كبرى وجائزة دولية، فماذا حققت أنت؟.. طريقي طريق التحايل وخداع الحاكمين والبصق في وجوههم سراً، والضحك على عقولهم، وسلب أموالهم، وتجسيدهم في صور كاريكاتيرية وتقبيل أيدهم ظاهرا، والأصل في الباطن»‹13›. يظهر «ياسين» مثقفا ذكيا ومخادعا، ولكن عمق المقطع ومدلولاته الرمزية تعبّر عن (مثقف) انتهازي تحكمه إيديولوجية الثروة والشهرة (قلادة، جائزة). ناهيك عن كونه (مثقفا) غير فاعل في مجتمعه، حيث لا شيء يرجى من مثقف مخادع متحايل ينغمس في المال المجني من تقبيل الأيادي، فتتعطل لديه السلطة المعرفية التي تغلّب الانتقاد المباشر (ما جدوى البصق في الوجوه سرا؟)، وتتقوى لديه ملَكَة رصْفِ كلام زائف لا محالة يكرس رمزية الثبات السلطوي في (صور كاريكاتيرية) تتكرر باستمرار، ويجسد الانفصال الداخلي المرضي لهذا الصنف من المثقفين.
إن مثقفا مزيفا مثل «ياسين الفينيقي» يعدّ راهنا نموذجا رمزيا للإنسان المثقف المنتصر للخطابات الزائفة، مما ينتج عنه، لزوما، هزيمة مدوِّية لهذا (الإنسان) حينما يكتشف معالم الزيف المتعددة المشكلة لكينونته ووجوده؛ وهو ما تعبر عنه رمزية الضياع والتّحلّل في قول «ياسين الفينيقي» التالي: “أين ذهبت كتبي؟ اختفت؟ تحللت في المكتبات دون أن يشتريها أحد”‹14›.
■ انتصار سلطة القناع:
يرى «فولفغانغ إيزر» (أن القناع بمثابة قناة يمكن بواسطتها تجاوز المحظور) ‹15›. ينطوي القناع، إذا، على جمالية امتلاك جرأة الخوض في المحظور، وعلى الاحتفاء بسلطة المبادرة المؤجلة حينما تكون الذات غير مزيفة بالأقنعة، وعلى الارتياح لإرادة التحول الدائم للذات والعالم من حولها. لهذا ثمة دلالات متعددة تؤطر (انتصار القناع) في رواية «التماثيل»، بناء على مداخل جمالية مختلفة. إن القناع، هنا، أداة فنية تعمّق الوعي برمزية الانحدار الإنساني الذي يوحي به محكي الرواية، انحدار يتخذ مستويات مختلفة ومتعددة، فيتكرّس الاختلال الفردي والجماعي، وتتعمق تراجيدية الكائن البشري في واقع نصي وخارج نصي مختل.
يتجلى ذلك أولا في انتصار القيم الذئبية، فتسيطر على الشخصيات قيم المكر، وتتأسس العلاقات على الخداع: «قلْ شيئا آخر يا صديقي، كيف لم أفهمْ إنك بالونة منفوخة من أكسيد الكذب»‹16›. إن انتصار قيمة الكذب خلخل العلاقة بين الأصدقاء الأعداء، وجعلها مبنية على الرغبة في مَحْوِ الآخر كي تتحقق كينونة الأنا، وهو ما تعبر عنه الاستعارة الحيوانية في قول السارد: «سأبتعد عن دروب العظايات والضباع»‹17›، واللوحة التشبيهية التالية: «ياسين حيّة أسطورية، سمها كالمحيط»‹18›. إنه منطق الصراع الحيواني، حيث يتراجع قانون اللغوس (العقل) فاسحا المجال لسلطة الغرائز، فتتعمق جمالية الانحدار الإنساني.
وتتجلى رمزية الانحدار الإنساني ثانيا في تراجيدية التّعهُّر، لأنها تنتج واقعا نصيا، يحيل على واقع خارج نصي، تهيمن عليه سلطة القناع التي تجعل الصديق يمارس المحظور مع زوجة صديقه. بيد أن النذالة تأخذ طابعها التراجيدي المثير حينما يرتدي الزوج قناع الجهل بسفالة صديقه، بل يرى فيه (بديلا) له أثناء غيابه، مع ما يوحي به ذلك من مأساة الوعي بعلاقة التعهر التي تجمع الصديق بزوجة صديقه: «وإذا به ذات يوم يتصل بي ويقول بحماس:
ــ أين أنت يا أخي؟ تركتَ بيتك الذي كنتَ فيه تعيش؟ نرجس وندى يفتقدانك كثيرا. أنا لا أستطيع وحدي إدارته.
ما هذه السفالة؟ أي وغد هذا؟»‹19›.
ويظهر انتصار الاختلال والزيف ثالثا في هيمنة سلطة النفوذ والمال، فصار النص الروائي مفتوحا على دلالات هيمنة (المادة) على نظام العلاقات الإنسانية، وتحكمِّه في بناء صورة الشخصية ورسم معالمها: «انظر كيف كان ياسين مناضلا عانى سنوات طويلة ثم باع نفسه بدنانير»‹20›. يوحي هذا بثبات السلطة القائمة على تدجين (المناضلين) ذوي النفوس الضعيفة عبْر سلطة المال، فيصير الكائن البشري ذليلا أمام أعتاب السلطة والثراء، ومهزوما ومنهزما أمام الناس البسطاء والشرفاء. لذلك تنتصر نذالة الإنسان، وتشمخ حقارته، ويتقوى انبطاحه، حينما يرى الإنسان الحقير نفسه أمام المرآة دون أقنعة: «أمضي أنا ياسين العبقري وأصير ضفدعة في مسرح، وأنبح مثل كلب على باب قصر، وأغدو حيَّة في التجمعات الغاضبة»‹21›.
يتضح أن انتصار سلطة القناع يجعل رواية «التماثيل» توحي بانتصار زمن عربي انقلبت فيه المعايير، فصار الكائن البشري مخذولا في محيط تتهدم فيه القيم، وكائنا محكوما بتحوُّل ارتكاسي يعبّر عن الرؤية الحربائية للكثيرين تجاه الحياة والوجود، وعن ذوات تعيش أعطابا نفسية وفكرية أساسها التعدد في الوحدة، بوصف ذلك صفة سلبية، وإن كان (تجاوز المرء لذاته من خلال القناع يساعد الذات بأن تكون دائما مع نفسها بطريقة مختلفة)‹22›.
3 ـــ «التماثيل»: مستوى الانكسار:
إن الانطلاق من (مبدأ التكاملية) الذي يوحي ضمنيا بمؤامة الأضداد‹23›، يسعف في القول إن مستوى الانكسار داخل رواية «التماثيل» يتموقع في مسار مضاد لمستوى الانتصار، بيد أنه مكمّل له. ولهذا فإن الانكسار لا يمكن تبيّن دلالاته وأبعاده إلا من خلال الانتصار؛ فإذا كان هذا الأخير تؤسسه جمالية التعرية، فإن الانكسار داخل رواية «التماثيل» تبنيه جمالية الفضح. إن ما نقصده بهذه الجمالية هو أن انكسار شخصية «حسان يوسف» دال على إنتاج عالم رمزي يفضح الكثير من المكونات المجتمعية النصية والخارج نصية. ولا يقتصر الانكسار على الشخصية بل يصير فعلا دالا يمكِّن من فضح العالم الممكن بإبدالاته المختلفة. لذلك يشتغل الانكسار نصّيا بوصفه حالية مفضية لانهزام متعدد الشكل والهوية. وهذا ما يمكن إبرازه في ما يلي:
■ انكسار الهوية:
إن التراث الدلموني العظيم بالبحرين هو هويّة تعدُّ نتاج مجهود إنساني كبير، مما أهّل مملكة دلمون للتميُّز الحضاري، وبلوغ أوج ازدهارها كقوة سياسية واقتصادية مستقلة في الفترة ما بين 2000-1700 قبل الميلاد‹24›. إنه ازدهار أنتج تراثا غنيا في شكل آثار عظيمة: أواني مرمرية رائعة الصنع، وخرز اللازورد ومواد نحاسية أخرى‹25›..، لا محالة تتميز به مملكة البحرين عن غيرها من الأمم. بيد أن هذا التراث النفيس تقدمه الرواية بوصفه علامة رمزية، لكنها مهددة بالإنسان المنحرف:
«ــ ما هو عملك؟
ــ أبحث عن الآثار، وأخبئها من اللصوص ولدي كنز…
ــ أي آثار لديك يا عبدالمحسن ولماذا لا تسلمها للدولة؟
ــ إنهم يسرقونها ويبيعونها في الخارج»‹26›.
إن رمزية اللصوص وفعل السرقة تكمن في غياب أي روح وطنية، فتغدو السرقة فعلا رمزيا تتجرد بموجبه الذات السارقة من هويتها، ما دام التراث جزءا من كينونة الذات، وأحد عناصر تميّز الوطن. إن السرقة واللصوصية فعل عبثيّ يَنِمّ عن غياب وعي حقيقي، لدى الكثير من الفرقاء الاجتماعيين، بأهمية التراث الدلموني. وبالتالي فرغبة العديد من الذوات النصية (ياسين الفينيقي مثلا) في الاستفادة من تماثيل الآثار القديمة يعبّر عن أمرين؛ غياب وعي بالخصوصيات المميزة للجغرافية المحلية (البحرين) على المستوى التاريخي، وحضور الرغبة في مَحْو الهوية المحلية عَبْر بيْعِ التراث الذي يبدو مداهما بخسارة كبرى. ولذلك قد يكون نجاح الذات مرهونا بانكسار الهوية وخسارة التراث: «فتعالْ يا حسان إلى هذا المسرح.. دعني أتسلل إلى خلاياك الصامدة النائية، أرى تلك التماثيل الذهبية، أسطو على واحدٍ منها أو إثنين أسدد ديوني وأصنع شحما لعظام نرجس التي كنتَ تحبها مثلما أنا أحببتها»‹27›.
تتحدد الهوية، إذا، عند البعض بقيمة ما يدلُّ عليها، وليس بطابعها الرمزي والإنساني الممتد في الحاضر منذ آلاف السنين، فما لا يدمره الزمان يهدمه السلوك الأرعن (السرقة، البيع). إن التراث الوطني عند الكثير من الذوات النصية، حيث «هناك كنوز مخبأة ثمة خرائط، ثمة آثار وتماثيل وذهب منذ عهد الديلمونيين العظام»‹28›، لاتهمُّ رمزيته، ومكانته بصفته هويّة للكائن البشري البحريني، بل تفيد قيمته المادية، مما يعبّر عن انهيار للروح الوطنية، وانكسار للتمثل الإيجابي للهوية. لهذا فإن رواية «التماثيل» تتموقع ضمن ما يسميه د. «فيصل دراج» بـ(الرواية – الشهادة)‹29›، التي تقربنا، بمنطق الشهادة الفنية، من عالم إنساني انتصرت فيه الماديات على الأمور المعنوية، فانكسرت الهوية وبات التاريخ المشرق عرضة للزوال.
تحوِّل سلطة المال، إذا، التراث الوطني إلى «بضاعة ثمينة»، فيشتدُّ التنافس والصراع بين الذوات النّصية للحصول على تلك “البضاعة”، لكن ليس لحفظها من الضياع، بناء على وطنية سامية تهدف صوْن كل مكونات الهوية، بل للاستفادة منها وفق منطق الأولوية المادية: «نريدك أن تدلنا على مواقع الآثار المخبأة كلها. هذه ورثة المرحوم ولابد أن تنتقلَ لنا. نحن أهله وأصحابه»‹30›. يظهر أن الهوية التاريخية والتراثية (الآثار) مهددة بالضياع، ومحاطة بذوات راغبة في تشييد نسق الأنانية المفرطة، مما يوحي بالتعايش مع التراث النوعي للوطن عبْر بلاغة الضياع والتفريط. وكأن الروائي «عبدالله خليفة» في هذه الرواية يفضح المآل المؤسف الذي سيعرفه، أو يعرفه، التراث الدلموني العظيم في مملكة البحرين، كما يفضح الجماعات والأفراد العابثين بذلك التراث، لأنهم يفتقرون إلى روح وطنية عالية وهوية مكتملة، مما يعرضهم لمأزق وجودي وأخلاقي، هوية ناقصة، أو شعور بالذنب بعد ضياع الآثار التاريخي النفيس.
■ انكسار القيَّم:
صاغ «فلاديمير كريزنسكي» تمثيلا شجريا لمختلف النمذجات التي تتآلف بينها لإنتاج نص الرواية‹31›، فتبيّن من ذلك التمثيل أن (النمذجة القيمية) (modélisationaxiologique) أحد العناصر (النمذجات) المساهمة في بناء نص الرواية. وبهذا المعني يكون العنصر القيمي حاضرا في الرواية بما يلائم طابعها الجمالي من جهة، وخاصيتها المركبة من جهة ثانية. لذلك تتجلى القيَّم نصيا عبْر علامات نصية دالة وقابلة لقراءات مختلفة ومتعددة؛ قراءات تأخذ بعين الاعتبار الطابع التكاملي للنمذجة القيمية مع غيرها من النمذجات المنتجة للنص الروائي، وتمكّن من الحكم على تطوّره، لأن (فعالية تطور الرواية تقاس بوظيفة التوازن الدينامي للنمذجات المُدمَجة في الإنتاجية النّصية)‹32›. فكيف تتشكل القيم المنكسرة في رواية «التماثيل»؟
يتحدد البناء الجمالي والدلالي للقيم النصية في الرواية بما يناسب المتخيل النصي، لأن (خلق وقع جمالي ما هو نتاج القدرة على إعادة صياغة القيّم وفق مقاييس جديدة أو ضمن أشكال جديدة أو انطلاقا من رؤية فكرية أو وجدانية)‹33›. بناء على ذلك تتجلى نصيا معالم الاحتفاء بانكسار القيّم الوجودية، بوصفها قيّما يتحول بموجبها الوجود الإنساني إلى حالة من الضياع. وقد يصير الكائن البشري سجينا أو ميتا موتا رمزيا، فيزامل الموتى حيّا ويشابه السجناء في صورة رمزية تتأسس على جمالية التناظر؛ حيث يتساوى القبر ومقر العمل: «أنزل في سرادبَ وأدخلُ القبو، لتتقطع بي العلاقات بالصوت والنور والأجسام، لتبدأ علاقتي بالأصداء والعتمة والأشباح»‹34›. وقد يتشابه السجن ومكان العمل (البنك)، بيد أن السجين يطمح للحياة، في حين موظف البنك (حسان) يبدو «ميّتا» (محنطا) أو سائرا نحو موته الحتمي دونما أمل أو طموح: «وجدت نفسي عداد نقود قابعا في إحدى زنازين واجهة المصرف.. مطلوب منك أن تبتسم دائما وأنت محنّط ، تحركُ كل هذا الطابور وتغذيه بالحياة الورقية هذه، وأنت تسحبُ منك الحياة كل يوم»‹35›.
تغذي هذه الوضعية الوجودية سببيا وجودا معيشيا مُرعبا، مما يؤثر على نظام العلاقات الاجتماعية، فتنكسر قيم الصداقة والأخوّة والأبوّة. لهذا فالأُسرة تنبني علاقات أفرادها على معطيات مادية، وليس على معيار القرابة، في إشارة رمزية إلى تحكّم المال في كثير من قيّم العلاقات الاجتماعية التي يجب أن تتعالى على ذلك. يقول «حسان» متحدثا عن أفراد أسرته حينما بدأ العمل في قسم الأرشيف بالمحكمة: «أول نهار عمل، كان أخوتي وأمي وأبي في لحظة تجلٍّ تاريخية، أحاطوني من كل جهة، ونظروا لثوبي.. وأعطوني عطرا وورقة مالية صغيرة، بعد أن قدّموا لي لأول مرّة فطورا، ولم يتعاركوا معي»‹36›. إنها علاقة معقدة بين الأسرة، تدمّر القيم الإنسانية النبيلة، وتبني بدلها القيم التبادلية المادية التي ترهن كل علاقة أسرية بما هو مادي خالص. أما الصداقة فتصير جزءا من علاقة قائمة على الخداع والاحتيال، وهو ما تعبر عنه رمزية «الذئاب» و«الحيات» في قول السارد: «ليست لدي قدرة على مجاراة عائلة الذئاب هذه. ندى حسبتها كائنا ملائكيا تعود بأصولها إلى الحيات»‹37›.
هكذا ترسم الكثير من العلامات النصية المشكلة لمرجعية رواية «التماثيل» انكسارا مهولا لكثير من القيّم الإنسانية السامية والنبيلة. لكن ما نود الإشارة إليه هو انكسار القيم المعرفية؛ ونقصد بها القيم التي تجعل الكائن البشري النصي يدرك حدود تحركه، وتحرك الفرقاء الاجتماعيين الذين يتعايش معهم، مما يساهم في انتصار السذاجة وانكسار الذكاء. وتعتبر شخصية «حسان يوسف»، في بعض امتداداتها الفكرية، تمثيلا دالا لقيم السذاجة المفضية لانكسارات شتى: «أين أوصلتني السذاجة؟ بعد هذا العمر عَليَّ أن أتعلّم»‹38›. إن التعثر الكبير لـ«حسان» ناجم عن سذاجته، فيتجاوز خطأ بخطأ فادح أكثر تدميرا للذات. إن الوعي بالسذاجة في السياق النصي للرواية ينفتح على مقولتين: حكمة العقل تعصم الإنسان من الزلل وتقيه الشرور والانهيارات المتتالية، وإرادة الخديعة التي تؤسس كينونة الكثير من الذوات النصية والخارج نصية الاجتماعية تهدم الآخرين وتجلب لهم الهم والمآسي. لذلك فالذكاء انتصار على حياة تتبدل باستمرار، والسذاجة انكسار أمام المبادرات الإنسانية المُدمِّرة والمبنية على «منطق» المنفعة وسُلّم الانتهازية.
■ تركيب:
خلاصة القول إن الروائي عبدالله خليفة بنى روايته «التماثيل» بحس فني متميز على جمالية التوازي بين الانكسار والانتصار، حيث أنبنى الانكسار في رمزيته الراهنة على ضعف الهوية، وتراجع الحس الوطني، والارتكاس القيمي، والقلق الوجودي. بينما تأسس الانتصار على الادّعاء والنفوذ والانتهازية. من هنا تصير المفارقة بين فعلي الانتصار والانكسار إحدى الخصائص الجمالية للتخييل في رواية «التماثيل». بيد أن ذلك لا ينفي الامتدادات الرمزية للانتصار والانكسار داخل النص الروائي وفق بنية سببية، فيصير الانتصار نتيجة الانكسار أو العكس، مما يجعلهما عنصرين متلازمين تعبّر عنهما رمزيا بعض المعطيات النصية مثل الشخصيات، فيظهر «حسان» المنكسر، ويتجلى «ياسين» المنتصر: (كان هو «ياسين» يتقدم في المسرح المُضاء.. كنت في هوة الظلام)‹39›، (ياسين شكلي الآخر، شبحي الواقف ورائي) ‹40›.
________________________
ناقد من المغرب‹1›- عبدالله خليفة، التماثيل، رواية، الدار العربية للعلوم- الاختلاف، بيروت – الجزائر، ط1 ، 2007.
‹2›- التماثيل، ص: 7 .
‹3›- التماثيل، ص:14 .
‹4›- التماثيل، ص:25 .
‹5›- التماثيل، ص:109 .
‹6›- التماثيل، ص: 126.
‹7›- التماثيل، ص: 173.
‹8›- التماثيل، ص: 180.
‹9›- د. حميد لحمداني، القراءة وتوليد الدلالة: تغيير عادتنا في قراء النص الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء- بيروت ،ط1 ، 2003، ص: 91.
‹10›- التماثيل، ص: 25.
‹11›- التماثيل، ص: 29.
‹12›- التماثيل، ص: 84.
‹13›- التماثيل، ص: 130-131.
‹14›- التماثيل، ص: 140.
‹15›- فولفغانغ إيزر، التخييلي والخيالي من منظور الأنطربولوجية الأدبية، ترجمة: د. حميد لحمداني – د. الجلالي الكدية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط1 ، 1998، ص:89 .
‹16›- التماثيل، ص: 30.
‹17›- التماثيل، ص: 146.
‹18›- التماثيل، ص: .144
‹19›- التماثيل، ص: 71.
‹20›- التماثيل، ص: 140.
‹21›- التماثيل، ص: 98.
‹22›- فولفغانغ إيزر، التخييلي والخيالي من منظور الأنطربولوجية الأدبية، مرجع مذكور، ص:97.
‹23›- تيودور زيولكوفسكي، أبعاد الرواية الحديثة، ترجمة: د. إحسان عباس وبكر عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط1 ، 1994، ص:41.
‹24›- هاريت كرافورد وآخرون، مستوطنة سار ودلمون المبكرة، ترجمة وتحقيق: خالد السندي وعلي يعقوب، البحرين الثقافية (مجلة)، البحرين،عدد 15، السنة الرابعة، يناير 1988، ص:7.
‹25›- نفسه، ص:10.
‹26›- التماثيل، ص: 46.
‹27›- التماثيل، ص: 98.
‹28›- التماثيل، ص: 99.
‹29›- د. فيصل دراج، الرواية وتأويل التاريخ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء- بيروت، ط1 ، 2004، ص: 213.
‹30›- التماثيل، ص: 160.
‹31›- W. Krysinski, Carrefours du signes: Essaissur le roman moderne, Mouton étideur, La Haye, Paris- New York, p: 5.
‹32›- Ibid, p: 49.
‹33›- سعيد بنكراد، النص السردي: نحو سيميائيات للإيديولوجيا، دار الأمان، الرباط، ط1 ، 1996، ص: 56.
‹34›- التماثيل، ص: 13.
‹35›- التماثيل، ص: 54.
‹36›- التماثيل، ص: 15.
‹37›- التماثيل، ص: 110.
‹38›- التماثيل، ص: 165.
‹39›- التماثيل، ص: 120.
‹40›- التماثيل، ص: 147.
__ATA.cmd.push(function() { __ATA.initDynamicSlot({ id: 'atatags-26942-62e98356e3569', location: 120, formFactor: '001', label: { text: 'الإعلانات', }, creative: { reportAd: { text: 'الإبلاغ عن هذا الإعلان', }, privacySettings: { text: 'الخصوصية', onClick: function() { window.__tcfapi && window.__tcfapi( 'showUi' ); }, } } }); });July 29, 2022
عبـــــــدالله خلــــــــيفة: سذاجةٌ سياسيةٌ
 سذاجةٌ سياسيةٌ
سذاجةٌ سياسيةٌتدهورَ الوعيُّ النقدي التحليلي الموضوعي، فصاروا سياسيين سُذجاً.
يغدو الشرقُ مثل الغرب، واليسار مثل اليمين، والوطنيةُ مثل الطائفية.
ليبراليٌّ لا تمتدُّ ليبراليتهُ لتحليلِ الرأسمالية الحكومية التي تمنعُ تطورَ ليبراليته الشاحبةَ الشعارية إلى وعي ديمقراطي متغلغلٍ في البناء الاجتماعي السياسي، فهي ليبراليةُ المنافع الخاصةِ المحدودة المدفوعة الثمن.
الديني لا يعرفُ الإسلامَ وجذوره وفرقه وثقافته ويوجه الأوامرَ السياسية إلى(الشعب).
الماركسي لا يزال يحفظ المعلبات الروسية وقد أهترأت ولم يُعدْ النظرَ في دراساته وتعليبه.
المنهجُ اللاجدلي سائدٌ؛ مع النظام ضد المعارضة، مع المعارضة ضد النظام، مع الإصلاحات والسكوت عن كشوف المال العام المخرومة، مع الديمقراطية والعنف، مع الديمقراطية وهيمنات الأقليات السياسية الاجتماعية، مع النيران المشتعلة ومع تطوير البلد، مع الأغلبية والأقلية أيهما يدفع، مع التهييج والتخريب والإصلاح أيهم يرفع.
في هذا الاهتراءِ السياسي الشعاري يكمنُّ إنهيارُ عمليات الوعي خلال عقود، الكُتاب الذين شاخوا صاروا مثل الكتاب الشباب، ليس ثمة مقاييس، وليس ثمة تراكمٌ للوعي الوطني، فالاهتمامُ بالسياسة اليومية وتحريكها في ظل مناخات نفعية، صراعية، على مستوياتٍ عدة متناقضة، تدفع بالقادرين إلى إستغلال أي مادة وتوظيفها في الدعايات.
تحول الكاتب إلى دعائي، والقادرون يريدون الدعاية لا البحث عن الحقيقة ومعرفة المشكلات وتغييرها فهم أسرى لوضعهم المعقد.
الكتاب والمفكرون والأدباء والفنانون أُحبطوا على مدى عقود وتآكلت كتاباتُهم وأعمالهم بسبب الرقابات والحصارات والمشكلات المادية، ولهذا فإن أية قامات قصيرة متقزمة تستطيع أن تصارعهم وتحصل على الأضواء ويشار إليها بالبنان الملون.
هم أيضاً كانوا يتآكلون فكرياً إبداعياً، والإبداع يريد حواراً دائماً مع الواقع، مثل هذه الظروف تدفع إلى إختلاط المقاييس وضياعها، وحين تتحول هذه إلى ميدان السياسة تغدو كوارثَ، فالشباب المسيطر على التيارات السياسية هو من هذه التُربِ المدَّمرةِ معرفياً، المؤدَّلجةِ الشعارية المتعصبة، وشيوخُ التياراتِ والمعتقون فيها هم كذلك تآكلتْ أدواتُهم التحليليةُ المعتمدة على الشعارات بالصور السابقة؛ مع الشرق ضد الغرب، مع الاشتراكية ضد الرأسمالية، مع الإسلام ضد الكفر، وهذه العقلية لا تستطيع أن تواجه وضعاً معقداً مركباً، صار أكثر وعورة من التاريخ السابق، لأنه غدا متطوراً أكثر، يتطلب معرفةً واسعة، ومجموعة من العلوم مواكبة، ولكن الشباب تركوا الدراسةَ وضعُفتْ علاقاتُهم بالمعرفة وغدت الجريدةُ الصديقة هي التي تضخُ في عقلهم الشعارات والموادَ الصغيرة المهيّجة، والأخبارَ الفاعلة في الإصطدامات الطائفية الاجتماعية.
عقلية القداسة السطحية الانفعالية هي ذاتُ مصدرِ وحيٍّ واحد؛ أما وأما، مع أو ضد، فالحقيقةُ تأتي من جماعتنا، ونحن مرابطون ومتخندقون ولا نسمعُ ما يقولهُ الخصوم.
ويسهل في هذا المناخ المسموم تحرك أي قوى إنتهازية، والإصطياد، وتحول البعض لكتابٍ فجأة، وسياسيين بارزين للمعارضة وهم من أقصى اليمين المتصيد، أو يتحول اليساري المؤيد لجيفارا وحرب العصابات إلى ليبرالي وحصالة.
مشروعاتٌ حزبيةٌ وسياسية ثقافية وفكرية لم تكتمل، تشعرتْ ثم خَوتْ، ثم تراقصتْ على الحبال.
الأرضيةُ المحفورةُ بهذ الشكل يغيبُ عنها التراكمُ الاجتماعي الديمقراطي، فصراعُ الطوائف يعرقلُ تنامي البناءَ الاجتماعي صوب صراع الطبقات الديمقراطي المتصاعد نحو المزيد من التقدم، ولهذا فإن تيارات العمل السياسي لم يقدها مناضلون ناضجون، بعيدو النظر، أدركوا الفروقَ بين صراع الطوائف وصراع الطبقات، ولكيفيةِ البناءِ التراكمي الديمقراطي، وخلقِ الوحدةِ المؤدية للتنوع، لهذا تكون قراراتُهم الساذجة مدمرةً، وفجأة يُسكب الدمُ وتنهارُ مؤسساتٌ وتتفاقم حربٌ أهلية.
يحدثُ غيابٌ للتحليل المَوضعي للمشكلة المحورية، فلا تُفهم ما هي المشكلة المحورية، بل تتعدد مواقعها نظراً لمنهج السذاجة، ولتصادم عقليات السذاجات، لكون البناء الاقتصادي الاجتماعي غير مفهوم، وسيرورته غير مُدَّركة، وتحديد حل التناقض يضيع.
الرأسمالياتُ الحكوميةُ مسارُها الموضوعي إلى الرأسماليات الحرة بمخاطرها الجمة، وهذا يجري في موازين قوى كل دولةٍ بأشكالٍ مختلفة، وتفكيكُ الصلاتِ بين المال العام والمال الخاص هو بؤرةُ الموقف لكل مجتمع، وكل تيار له رؤية لهذا التطور، حين تنضج أدواته الفكرية السياسية، ويراكمُ المعرفةَ من تجارب القرن العشرين الخائبةِ الكثيرة والناجحةِ النادرة، ولهذا فإن هذا النظر يتحول من السذاجة المفتوحة على الانتهازيات المختلفة، إلى السير الموضوعي الوطني المتعاون من خلال أطراف عدة ذات مصالح مختلفة ومتوحِّدة لتجاوز مشكلات محورية تمثل عقبات التطور.
تجاوز السذاجة ومخاطرها بالدرس العميق والعمل التعاوني العريض.أفــــــــــــــق
عبــداللـه خلــــــــيفة
July 28, 2022
عبـــــــدالله خلــــــــيفة: حريات النساء مقياس للديمقراطية
 حريات النساء مقياس للديمقراطية
حريات النساء مقياس للديمقراطيةكلما ازدادت حريات النساء كان التقدم الاجتماعي أكبر، وتواجه الدول والجماعات المحافظة اليمينية و(اليسارية) اختباراً قوياً لمدى إيمانها بالديمقراطية اللفظية حتى الآن، ويتحدد ذلك بمدى قدرتها على إحداث تطورات كبيرة في حياة النساء في وضع يهيمن فيه الذكورُ هيمنة مطلقة في هذه الدول والتنظيمات. تعود الهزائم التي حلت بأنظمة التحرر والقومية والليبرالية الضعيفة إلى عدم إيلائها هذا الجمهور القابع في البيوت والتراث المجمد عناية كافية، فقد قادت هذه الأنظمة جماعاتُ الذكور المحافظين، ومهما كانت إيجابياتها على صعيد محاربة الاستعمار والتخلف فإنها تركتْ النساءَ في ظلام العصور الوسطى. وقد بدأت الأنظمة الليبرالية تقدماً مهما على هذا الصعيد فتفجرت شعارات تحرر النساء وظهر منظرون لهذه الحريات على صعيد الحريات الاجتماعية والسياسية المحدودة، لكن تلك الحريات لم تصل للعمل الصناعي وتحجيم العائلة الأبوية الكثيرة الأعداد والقابعة في الأمية والجهل والأساطير، وفي قوانين الاعتقال التي تـُبرر باسم الدين. بل ان الأحوالَ ازدادتْ سوءاً مع الأنظمة والحركات القومية العسكرية والدينية الشمولية، فقد تضخمتْ المدنُ العربية الصغيرة بأعدادٍ هائلة من الريفيين والبدو التي حملتْ الأشكالَ المتيبسة المحافظة وحاربت بها التطورات الوطنية والليبرالية الصغيرة في المدن العربية. وهكذا تحملتْ النساءُ تراجعات الحركات السياسية العربية وتصاعد ذكوريتها، فامتدت الدكتاتورية من البيوت إلى الشوارع والأحزاب والجماعات والحكومات. وكان التراجعُ ظاهراً على صعيد الملابس، وأدوات الزينة، وفرض الهيئة الذكورية على النساء، وتحجيم الجمال ودوره الخلاق، ونشر القبح، والأشكال الرهبانية وأمراض السمنة، ولكن النساء كن حتى في مثل هذا التصاعد للدكتاتورية كن يقاومن داخلها، بتغيير اللباس والبحث عن علماء دين يتسمون بالنزاهة والبعد عن الإقطاع، وهم نادرون محاصرون، فعاد عهد الجواري على نحو كثيف، وربحَ الكثيرُ من الرجال حريات البذخ واللهو والاسراف وتضييع ثروات الأمم الإسلامية. ولكن الأغلبية من النساء يتسمن بالخضوع ويزايدن على علماء الدين في محافظتهم فيزددن عبودية، نظراً لعدم درايتهن بالإسلام والحداثة، وعدم تمييزهن بين الإسلام كثورة نهضوية توحيدية ومشروعات الحركات الطائفية الرجعية التمزيقية لجسد الأمم الإسلامية. ساعد في هذا استيلاء قادة القرويين والبدو على مقدرات المنطقة وبثهم الشعارات المحافظة، وتصاعد مشروعاتهم وتكاتفهم وتكوينهم أحلافاً منظمة، وتمزق الحركات العلمانية والوطنية والتحديثية. صار بعض الرجال يطارد بناته لأنهن يكتبن ويقرأن، أو لأنهن يظهرن على المسرح يشاركن في عروض مسرحية خلاقة، فكان الوأد الجاهلي المتعدد الأشكال للبنات. في حين وجدنا في مرحلة سابقة آباءً أميين يفخرون بكتابة وحضور بناتهم الفكري. لا يعود هذا الحضور المحافظ لهذه الجماعات أساساً بل للتكوينات الاقتصادية الأساسية في كل بلد، فالحكومات العربية لا يهمها النسيج السكاني الاجتماعي برجاله ونسائه بقدر ما يهمها السيطرة على الثروات في مشروعاتها غير المراقبة، التي تخضع لراهن الربح والفائدة المادية، وليس لهدف تقدم السكان ككل. لدينا في البحرين عدة آلاف من النساء لا يشتغلن في الخارج بل يعملن في بيوتهن الخاصة، وهناك الملايين في كل بلد عربي بمثل هذا الوضع، في حين تأتي العاملات والموظفات الأجنبيات للاستيلاء على وظائفهن، ولا يهتم رؤوساء الشركات بالعاملين فما بالك بتطور الحضور النسائي في الأعمال المختلفة؟! يعتمد الحضور النسائي التحرري على تطور معيشة الطبقات الفقيرة، ومدى اتساع تعليمها، فهي المكان الأساسي لوجود الذكورية المحافظة والشمولية، وكلما ترقت في أجورها ووظائفها ومساكنها وثقافتها صعب تغلغل القوى الشمولية بينها. كما يؤدي هذا إلى عمل النساء واتساعه، وهو أمر يعمق كذلك من تطور معيشة هذه الطبقات، فلا ترغب في التوجه للمزايدات السياسية، وتعطي البنات حقهن من العمل والتعليم والثقافة. إن طبقات معدمة جاهلة لا يمكن إلا أن تجعل نساءها أكثر تخلفاً وإنتاجاً للتخلف. ومهما فعلت الأنظمة والحركات الدينية الشمولية من اضطهاد للنساء فإن الكثيرات يجدن ثغرات في نظام القمع الشامل هذا، فكل هذه الدول والجماعات الدينية المحافظة لها ظاهر وباطن، ادعاء بالتدين وتكالب على المنافع ولذائذ الحياة، فتظهر أنظمتها وحركاتها بهذا الشكل المشروخ المنافق، فاللافتات تقول: طهر ونقاء وصرامة، والباطن عمولات ومحرمات، سوق علنية (بيضاء) وسوق باطنية سوداء، أغلب الأشياء محرمة في الظاهر وصارمة ولكن في الباطن كل شيء مسموح وحسب أفضل الأسعار. ولهذا فإن الكثير من النساء المتمتعات عموماً بالدهاء يجاملن هذه الحركات والأنظمة وينسقن مع أغنيات الفضيلة الزاعقة فيها، ولكن يكون لهن باطنهن ومكرهن الخاص. غرائز البشر وأخطاؤهم ونواقصهم لا يمكن القضاء عليها بالخطب التي يعتقد المحافظون انها الوسيلة المثلى، ويجاورها العقوبات الصارمة، وهو أسلوب في ردع الإنسان ثبت فشله، وليس أفضل من المكاشفة والوضوح وتغيير الإنسان عبر ظروفه الموضوعية، ودعوته لخيارات الخير، ويبقى هو سيد مصيره، فإذا تجاوز القانون خضع لعقوباته. فوفر للنساء خيارات العمل والثقافة والرقي ثم حاسبهن على خياراتهن. أما أن تقمعهن وتسود عيشتهن فسوف يمكرن بك ويجعلنك أضحوكة وأنت تعتقد أنك سيد الفضيلة. لكن الدول والحركات المحافظة لا توفر ذلك لأغلبية النساء، فهن عاطلات في البيوت، يخضعن للسحر والثقافة المتردية للفراغ، فيجدن في الأزياء والعطور ومناكدة الأزواج وسوء تربية الصغار وجودهن الزائف وقد اُنتزع وجودهن الحقيقي. فتجر النساءُ الرجالَ المحافظين لهذا المستنقع الاجتماعي، فيؤسس الرجالُ بيئات متعة زائفة، ومجتمعات ذكورية خاصة بهم، ونفقات بذخية تدمر الأسر، فيكون المجتمع قد خسرَ رجاله ونساءه معاً. ونتاج ذلك حشود من النسوة في المحاكم ومعذبات ومطلقات وعيال مشردين، ويقوم الفقهُ الذكوري الجامد بمنع الإصلاح عن طريق الشرع، وعقاب الرجال الفاسدين.
July 27, 2022
عبـــــــدالله خلــــــــيفة: الأزمة العقلية للثورة
 الأزمة العقلية للثورة
الأزمة العقلية للثورةيُلاحظ في تاريخ المسلمين المعاصر ترافق الايديولوجية الدينية مع القومية عدة عقود، ثم نرى خفوت القومية، وكذلك ترافقها مع الايديولوجية اليسارية، ثم خفتتْ هذه كذلك.
ما هي الأسباب التي جعلت من الايديولوجية الدينية بهذا الاستمرارية؟ وهل فعلاً تمتلك الخواص المطلقة وأنها هي الخالدة؟
إن الايديولوجيات الدينية ذات تاريخ طويل جداً، وهي ذات مكونات مرنة: السحر، والنضال لتغيير حالة تخلف كبيرة، ثم سيطرة قوى التخلف في مرحلة تالية أكثر تطوراً، واعتماد الغيب، وتعددية الإيحاءات والتفسيرات التي لا تنفد، والارتباط بالمطلق، وبمركزية الشخوص الإعجازية البطولية (الذكورية) غالباً والنسائية نادراً، والدوران حول العبادات كشكلانيةٍ وهوية مركزية للجماعات، والفقهية الجزئية لرفض أو مسايرة الأحوال الاقتصادية والاجتماعية.. الخ.
تعود هذه المحاور لما قبل تكون الأمم، وتعود للجماعات القبلية الموغلة في القدم، حيث تشكلتْ العقلياتُ الدينية الأولى عبر صراع الأرواح الخيرة والشريرة، ثم حين تكونتْ الأديانُ انتقلتْ هذه المكونات إليها، وحين تشكلت الشعوب والأمم، دخلت تلك المكونات في ثقافتها، فما هو قديم غيبي سحري يهيمن على المكونات العليا، وحتى في تكون قوميات العصر الحديث غربية وشرقية، تدخل تلك المكونات القديمة.
طرحت التياراتُ القومية واليسارية في بادئ وجودها لافتات علمانية وعلمية ورغبات قوية في كنس الخرافات والتخلف، وكانت مستفيدة من رأسمالية خاصة متقدمة في الغرب ومن رأسمالية حكومية في روسيا والصين خاصة، فكان التقدمُ الصناعي العالمي يفرضُ تحولات كبيرة في البنى الاجتماعية المتخلفة، ومن ضرورة انتشار الوعي الموضوعي للظاهرات.
في البدء النهضوي العربي تشكلتْ رأسماليةٌ خاصة ديمقراطية جنينية بفعلِ التجارة وشكلتْ وطنيات عربية دفعتْ عمليةَ الوعي الموضوعي وفي اتساع تحليل الظواهر الفكرية والتراثية خاصة، لكن قواها الإنتاجية تكلستْ بتوجهها للملكيات الزراعية والعقارية والمالية وبالتقصير في الإنتاج الصناعي، فتحالفت مع القوى الدينية المحافظة، وتزاوج ملاك الأرض وتجار المدن.
التوجهات الاشتراكية في الشرق قفزت بالتحولات الاقتصادية إلى مدى أكبر، لكن ملكيات الدول الحكومية الرأسمالية قادت في النهاية للمحافظة والبيروقراطية وتوقف تطور العلوم الاجتماعية خاصة.
استند القوميون واليساريون العرب إلى هذه المنتجات، ونهضتْ بهم إلى حين، لكنهم لم يكونوا كتلك الدول والشعوب فليس لديهم إنتاج مادي يسند عقلياتهم المتفتحة على العلوم، وبهذا فقد أخذتْ الأحزابُ القومية واليسارية العربية تتوقف عن التطور السياسي.
كان إدخال العامة مفيداً في انتشارها وسط الجمهور والجدل مع ظروفه ونضاله، لكن حين تدهورت القيادات فكرياً ولم تتطور فلسفياً وفكرياً، فإن الموروثات الدينية المحافظة التي يحملُها العامةُ أخذتْ تتغلغلُ بقوةٍ أكبر في هذه الأحزاب.
فالعمالُ يتحدثون عن الثورة لكنهم يقمعون نساءهم وبناتهم في البيت، كانت عقلياتُهم الدينية المحافظة أكبر من شعاراتِهم التقدمية، كانوا يعملون لزيادة أجورهم وتغيير ظروفهم الاقتصادية أما الاشتراكية فشعاراتُ حلمٍ اجتماعي. وحين تتصدع (الاشتراكية) قومياً وعالمياً تتبخر حتى تلك الشعارات. ويتم الرجوع إلى القبائل والأسر والمذاهب والقوميات.
ويقفز متعلمون لتوظيف تلك التحولات أو التراجعات لمصلحتهم، وفي الدول الاشتراكية والقومية والدينية كان الضباط هم المستفيدون الكبار فغيروا المسارات لما يلائمهم ويلائم جماعاتهم وطبقاتهم.
كان الارتباط مع الرأسماليات الحكومية الشرقية سواء أكانت ماركسية أم قومية أم بعثية ذا وجهين، وجه الثورة ثم وجه الثورة المضادة. ويغدو التراجع الأكبر في هذا كله نحو الدين، أي لهذا الوعي الغامض المتعدد التفاسير الذي يقومون باستغلاله لمصالحهم، وليس لتسليط الأضواء على أخطائهم، وليس من أجل التضحية العامة، بل يقومون بخداع الناس مرةً أخرى، ويدغدغون مشاعرهم الدينية التي لم تنطفئ، وسرعان ما تتبدل الأسماء والأزياء والشعارات وتظهر الصلوات.
الدينُ يظهرُ مرةً بشكل ثورة، إيقاظية محولة للتاريخ، ومرةً بشكلِ خداع وأفيون. مرةً يظهرُ بشكلِ بطولةٍ وتضحية كبرى، ثم يغدو أداةً للتضليل، يتوجه إليه اللصوصُ يطمسون سرقاتهم، وانهياراتهم الداخلية، ولكن لماذا يحدث ذلك؟ وكيف يتحول الثوري المكافح إلى لص أو انتهازي؟
كلُ لحظة دينٍ تأسيسيةٍ بطولية هي لحظةُ يسار.
وكلُ هزيمةٍ لرموزِ الدين في لحظةٍ تالية هي لحظةُ يمين.
مثلما هي ثوراتُ الشرق التأسيسية الحديثة كانت ثوراتُ الأديان ترتعش بين السحر والعلم، بين الغموض غيرِ المسيسِ الواقعي وذي القفزات في الحلم الاجتماعي، وبين الإمكانيات الموضوعية المحدودة لزمانهم، كان الأنبياءُ قادةَ ثوراتٍ، وتحولاتٍ، في ظلِ ظروفٍ صعبة رهيبة، وكان عليهم أن يدفعوا الضرائب الثقيلة لتحدياتِهم سواءً كانت عذاباً في حياتهم أم كوارث لأهلهم فيما بعد.
هناك التداخل بين السحر والنبوة، حيث يستمدُ الداعي العديدَ من أفكارهِ عبر الغيب، وعبر مخاطبةِ قوىً مفارقةٍ تمتلكُ معرفةَ المستقبل، وتحديدَ المصير، وتحديدَ العالم ومسارَهِ كليا ونهائيا، ومع هذا تبقى اللحظات اليومية مجهولة، ومصير الحركة السياسية الدينية متعلقاً بالخطوات الذكية على الأرض وبمعرفة القوى الاجتماعية وكيفية جذب العامة وعزل قوى الطغيان.
لكن التحولات التكتيكية تبقى مفهومةً وعزل الملأ الارستقراطي مفيداً لتغييرات كبيرة، ويظهر هنا الحلمُ الغامض السرمدي، بظهورِ دولة الفقراء وانتصار المعذبين في الأرض كليا، وإن الذين استضعفوا في الأرضِ سوف يُمن عليهم ويكونون هم الوراثين.
هو تبشيرٌ سياسي بانتصار الكادحين في بعض الأديان التام والنهائي، لكن ما يجري على الأرض يمضي بخلافِ ذلك، فالأغنياءُ هم الذين يصعدون، بسبب أن صعود الفقراء ظل في حالةِ الحركة الثورية، التي تهزُ قوانينَ التطور الاجتماعي، وتلغي بعضَ أوجهِها في لحظةٍ استثنائيةٍ تاريخية، ما تلبث أن تزولَ لأنها لحظة غير تقليدية، عابرة، ثم ترجعُ قوانينُ التاريخ في الأنظمة الاستغلالية، ويعودُ الأغنياءُ للسيطرةِ على مقاليد الحكم، وتعودُ الثروةُ “لأصحابها”، حتى يأتي زمنٌ مختلف يلغي التفاوت، له قوانينٌ أخرى.
وتدفعُ قوى الحلم الثوري ضريبةً مضاعفة بين صعود الثورات وهبوطها، فالنبي موسى يُمنع من دخول الأرض الفلسطينية ويحدث انقلابٌ عليه، والنبي عيسى يجري ما جرى له من عذاب بتعدد الروايات الدينية، والعائلة النبوية المحمدية تجرى تصفيتها بشكلٍ دموي رهيب وكذا الكثير من الصحابة وأصحاب حلم المساواة، ويعدمُ أهلُ المقصلةِ الفرنسية نبلاء وثوريين كباراً، ويصفي ستالين أبرزَ قادة حزب الثورة والكثيرين من العامة.
في منطقة التحولات الثورية العاصفة يصعدُ الفقراءُ وتظهرُ رموزٌ منهم، وهي لحظةٌ تبينُ الاستثناء والبطولة وتحطيم معايير الذل والخضوع وكسر عالم الطبقات، لكنها مجردُ لحظةٍ ثم تأتي القاعدة.
تظلُ الشعوب تعيشُ في الحلم، في لحظةِ الاستثناء والبطولة تلك، وترى انها تاريخها الحقيقي، غير الزائف، لأنها وجدتْ فيها روحَها الحرة الضائعة في عوالمِ القهر.
لا يخلو أي قائد ثوري حديث في الشرق خاصة من الجمع بين العلم والسحر.
حين نقول إن قائد ثورة أكتوبر يجمع بين العلم والسحر لن نكون مغالين. بين برنامج الكهربة وتوزيع فوائض الإنتاج على العاملين، ثم بين برنامج إزالة الاستغلال ومحو الطبقات، ثمة هوة كبيرة، في الطرف الأول يحلُ البحثُ والعلم، وفي الطرف الثاني يحلُ السحرُ.
دائماً هنا في الثورة حس الأبدية، والمطلق، وحس السيطرة على التاريخ إلى نهايته، فتحدث فترةُ الاستثناءِ الثوريةِ البطولية بضع سنوات أو بضعة عقود ثم تعودُ القاعدة، بسبب مستوى سيادة أساليب إنتاج موجودة ومتنامية قبل الثورات وبعدها.
الإسلامُ التأسيسي لم يعرفْ ما هي طبيعة علاقات الإنتاج السائدة لدى البشرية القريبة منه، وفي عالمهِ البدوي الحر، تصورَ إمكانيتَهُ المطلقة على صنع التاريخ، وكون القوة والعدالة النسبيتين بين الناس كافيتين لزوالِ الشرِ والاستغلال إلى الأبد.
لكن العالم الأرضي الواقعي كان يعيش زمن الانتقال من أشكال الإنتاج العبودية والمشاعية والبطريركية إلى أشكالِ الإقطاع، التي انتشرتْ وسادتْ في آسيا وأوروبا، وهي تجعلُ من ملكيةِ الأرض وخراجها أساس الوجود السياسي للدول.
وكان زمنُ الانتقال في عصر روسيا الاشتراكية هو زمن الرأسمالية العالمية واكتساحها الأرض. لكن الوعي السياسي المغيب عن العلوم يتصور انه زمن الانتقال للاشتراكية. هو غيبٌ بشكلٍ آخر، ولهذا يتكون الماركسيون بشكلين علمي شعاري وديني غائر.
هنا لابد للحلم والسحر من أن يتدخلا ليعطيا للعاملين إمكانيةَ التحليقِ في أجواءِ الفضاءِ المليئةِ بالمن والسلوى، وهم يدفعون ضرائبَ العمل والتضحية، مثلما أن جمهورية إيران تجعل البسطاء يطيرون بأجنحة الأئمة في أجواء الملكوت الرحبة، وتتكاثر مقابرهم ثم تتكاثر سجونهم في مرحلة لاحقة، مثلما أن جمهورية الحلم القومية العراقية تتحول فيما بعد إلى جهنم.
كانت الأزمة السياسية لجمهورية الإسلام التأسيسية تظهر على شكل وامض، لا يُلاحظ على السطح. قدرة الجمهور الشعبي على حشد القوى وإيجاد التوزيع العادل للخيرات قدرة نسبية، فهي من دون تقاليد عريقة، ومن دون مؤسسات سياسية متجذرة في الأرض، وقوى الاستغلال لا يحد تاريخُها حد، والأنانية أقوى من التضحية في البشر بكثير.
نلاحظ الأزمة العقلية لقوى التغيير في ظهور حالات فكرية سياسية غريبة، فلأول مرة يظهر متصوف، يغرقُ في العبادة، وينأى عن العمل. وظهر ذلك في البداية، تعبيرا عن ضياع سيطرة العقل على اللامعقول السياسي المتصاعد!
هناك حكمُ السماء وهناك التوجيه الإلهي المصون ولكن الدنيا تخرجُ عن السيطرة وتنفلتُ الغرائزُ وكلٌ يهتمُ بنفسهِ ومصالحهِ بعد عقود من النضال المشترك والتضحيات، فيظهرُ الملأُ الاستغلالي مجدداً!
تباينُ طرق الخلفاء الراشدين تعبرُ عن عدم القدرة المتصاعدة على السيطرة على الوضع السياسي المنفلت من عهد الثورة إلى عهد (الاستقرار) الاجتماعي، أو قل عهد الأنانية، أي عهد المَلكية، عهد الأغنياء الكبار المسيطرين!
الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) يفرضُ سيطرةً قويةً على هذا الانفلات، على الانبعاث التدريجي لحكم الملأ، ويشعر في نهايةِ حكمهِ بالتعب من هذا الجهد الهائل.
لدى الخليفة عثمان بن عفان (رضي الله عنه) تتضحُ عمليةُ الانفلاتِ الأولى، وصعود قوى الاستغلال.
في عهد الخليفة علي بن أبي طالب (رضي اللهُ عنه) تتفجرُ العمليةُ وتصيرُ حروبا، ولا ينفعُ العدلُ والقوةُ في السيطرة على قفزة قوى الاستغلال إلى السلطة.
لقد قام الإسلام بتغيير، مثلما قام بالفتوح، وتبدلت خريطة القوى الاجتماعية، وصار الكثيرون أغنياء بعد أن كانوا فقراء، ولم يعد توزيع الثروة بالشكل القديم ممكن الاستمرار، وصار الحجاز مركز الثروة ونجد استمرت مركز الفقر!
إن تبدلَ السلطةِ هو ذروةٌ لتراكم طويل، وليس حدثا عجيبا غريبا!
وظلت كلمةُ (الخلافة) الغامضة تجمعُ بين من ارتفعوا إلى السلطة بسواعدِ الناس، ومن ارتفعوا إلى السلطة بسواطير وسيوف!
نلاحظُ أزمةَ اليسار والثورة هنا في (الخوارج). فدائما يبقى للنصوصيةِ الثوريةِ تلاميذها المخلصون، ومَنْ يَحاكمون تحولات التاريخ بالجملِ وشعيراتِها الدقيقة، ويَزِنون القادةَ والفترات بميزان الملموسية الشديدة، ولا يفهمون السببيات ولا قوانين التاريخ، ويظلون معلبين في الجملة (الثورية). إن ظروف نجد وفقرها في ذلك الحين وارتداداتِها عن الإسلام وحروب الردة التي أنهكتها، كلها أوجدت من بعضِ قبائلِها مادةً مناسبةً للتمردِ المعاكس للتاريخ، ووجهاً آخر من الإخلاص الحرفي للثورة، وقتلِها في آنٍ واحد.
لم يعطها الفقرُ تعليما مهما، وظل إنتاجُها العقلي قائما على الشفاهية والحفظ، ولذا تعاملت مع القرآن بشكل نصوصي حفظي، وغرقتْ في تلاوته بإيمان عاطفي شديد، وصار لديها تقطيعُ النصوصِ وغيابُ التاريخية، وفقدانُ الدراسة الفكرية أمورا متلازمة، وعبر هذا الوعي الذي رُكب على تمردِ القبائل وصعود الزعامات الذاتية وقوة الجماعية والمشاعية في هذه التكوينات العشائرية البعيدة عن بضائع المدن ونقودها، خاضتْ حروبا سالت فيها الدماءُ أنهارا وكلها من دون فوائد مهمة!
ظلت لدى الخوارج الفكرة الجنونية المطلقة التي تمثل الانفصام عن الواقع، بأنهم النسخة الحقيقية المستمرة والدقيقة للإسلام الأول، فهم يرون النصوصَ تنطبقُ عليهم تمام الانطباق، فهم العبادُ الزاهدون الذين يقرأون القرآن آناءَ الليلِ وأطرافَ النهار، وهم الذين يبكون حين يسمعون عذابَ النار، ويبتهجون أشدَ البهجة حين تذكر الجنة ولو من خلال غابات السيوف، وهم الفقراء يتلحفون السماءَ في حين غيرهم (من الكفار!) يعيشُ في الرفاه والقصور ويتحدث عن الإسلام! وحاول الكثيرون إقناعهم بأن هذه الآيات تنطبق على ظرف، وان لها معاني كثيرة متعددة، وهناك مستويات عديدة في فهم القرآن، أي حاولوا نقلهم للمستوى المركب المتعدد الدلالات للقرآن، لكنهم كانوا أصحاب منهج نصوصي حرفي أوجده فيهم وضعُهم الاجتماعي، وظروفُ الفقر الهائل الذي يعيشون فيه. وهذان المستويان، مستوى فهم الحضارة وقوى الرفاه، ومستوى فهم أهل البداوة البسطاء، فهمان يعودان لمستويين من مستويات المسلمين لا يجتمعان، وحين يحدث تقاربٌ بين الغنى والفقر، وتزول تناقضاتهما الرهيبة، تتقارب رؤى مشتركة. لكن النص الحرفي موجود لدى هؤلاء البسطاء وينقلونه مباشرة للحياة ويرفعون السيوف ويذبحون!
إن إنهيار المعسكر الاشتراكي وزوال التكوينات السياسية الثورية لذلك العالم المناضل ضد اللامساواة الاجتماعية والرأسمالية والإجحاف وغير ذلك من القيم، هو أمرٌ عادي لعمليات الثورات في التاريخ.
لكن الأزمة العقلية تنتج من خلال الأفكار المطلقة، التي تربط بين العمليات السياسية النسبية، والمقدسات، والأفكار الأبدية والشعارات الخالدة.
بعد تراجع كل ثورة يتشكلُ إضطرابٌ عقلي كبير. كلُ ثورةٍ وهي تغيرُ التاريخ، تخلقُ قوى إستغلال جديدة. مثلما رأينا في الثورة الإسلامية.
لقد تصور منورُ الثورة الغربية للطبقة الوسطى بدوامِ شعاراتِ الإخاءِ والحرية والمساواة، وسيادتها ليس في القارة بل في الأرض كلها! وفي العقود التي تلتْ كان النقيضُ يتحقق، ولكن على مدى القرون كان الأمرُ يتحقق.
إن الرأسمالية وهي تنقلُ الغربَ لمرحلةٍ جديدة كانت تنقلُ الشرقَ كذلك، عبر القهرِ والإستغلال والتطوير وبظهور ثورات جديدة. لكن بعد هزيمة ثورة الطبقة الوسطى الفرنسية خاصة أُبعدت الأفكارُ العقلانية المثالية وبذورُ الأفكار المادية، وعادت الطبقةُ الوسطى للأنجيل ولتدريسه في المدارس. كانت الهزيمةُ تستعينُ بالدين لتخفي تنصلَها من المبادئ الإنسانية التي أعلنتها ولم تواصل تطبيقها. ولترفع القومية كتعصبٍ وإستعمارٍ وبطش بالشعوب الأخرى!
والرأسماليةُ الحكوميةُ الروسية فعلت ذات العملية، فرفعتْ الشعارات المادية الفلسفية، كأدواتِ تحليلٍ عميقة ثم تجمدت لديها مع نشؤ التفاوت الطبقي الكبير، ثم تنصلتْ منها وعادتْ للدين كمظلةٍ سياسية. كانت الفلسفةُ الماديةُ أداةً لكشفِ ما يجري في الواقع من تمايزات طبقية، ومن هو الذي باع الثورة ومن سرقها.
في الصين الشعبية كانت التحولات نحو الرأسمالية الخاصة حادة ولكن أقل خطورة من روسيا، لأن الصين بلد هائلة السكان، وتحتاج لتطور عقلاني. في أقصى تطرف للثورة، أي حين أرادت أن تقفز بمبادئ المساواة الاجتماعية إلى حدها الكلي، ودمرت أي تمايز للثروة بين الأفراد، وأي تمايز للعقول، في ما يُسمى بالثورة الثقافية، رغم إنهذا التطرف بقى في دول أخرى ككمبوديا وأدى لقتل الملايين. لقد أقر الحزب الشيوعي الصيني بنمو الرأسمالية الخاصة تحت قيادته، ورغم الفساد المترتب على هذا، لكنه كان إبداعاً أكثر تطوراً من الروس. لقد تم الأعتراف بنسبية شعارات الثورة، وبعدم إمكانية الانتقال للمساواة الاجتماعية، وبضرورة التطور الصناعي الواسع على أشكال من تفاوت الثروة والثقافة. إن الشعارات الحالمة للاشتراكية تم تأجيلها لعصر آخر، وحلتْ برجماتيةٌ واقعيةٌ ليبراليةٌ شمولية كذلك في النظرة العامة والحياة السياسية المسيطرة. لقد أوقفت الدولة مسار الانهيار المتوقع، وتفكك البلد، وقفزت بالتطور الاقتصادي إلى آفاق كبيرة.
إن الارتباكات والتمزقات السياسية والعقلية لم تتوسع بفضل ذلك، وقادت عمليةُ التناسق بين القطاعين العام والخاص، إلى إفساح المجال للتطور العقلاني الهادئ، وغدت المعيشة ومطالبها أهم من الإيديولوجيا، ولم تتوجه السلطةُ للدين كمظلةِ خداع، لأن الدين لا يلعب دوراً في حياة الصينين عموماً، وهذا جزءٌ من الموضوعية المميزة في التاريخ الثقافي لهذا البلد.
ترينا هذه اللوحة المعقدة كيف أن مبادىء الدين، والعقلانية الأوربية، والمادية الفلسفية، هي مراحلُ تطورٍ طويلة لدى البشر، في ظروفهم المتحولة، وإذا عبرت هذه المبادئ عن مصالح الأغلبية الشعبية، فإنها تتطور وتكشف المشكلات، وحين تقوم بالدفاع عن الفساد والتمايزات الحادة في مستوى المعيشة، فإنها تتلبس بالغموض والدجل.
حين يزداد التطرف الديني فذلك تعبير عن إزدهار الفساد، وحين يتم التجريد والذاتية في العقلانية ويظهر التحجر في المادية، فهذا يعني كذلك تفاقم إستغلال الشعوب وفساد الأحزاب والدول التي كانت مناضلة، وتداخلها مع البيروقراطيات المستغِّلة للعامة.



