عبـــــــدالله خلــــــــيفة's Blog: https://isaalbuflasablog.wordpress.com , page 62
July 4, 2022
عبÙÙÙÙÙÙÙداÙÙÙ Ø®ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙØ© : جبÙر ÙÙÙØاÙ
جبÙر اÙÙ ÙÙØا٠: ٠دÙر شبÙØ© اÙÙصة اÙعربÙØ© اÙسعÙدÙØ©
https://www.facebook.com/100004799598166/posts/2151587875011178/?sfnsn=mo
عبـــــــدالله خلــــــــيفة: تطور الوعي الديني في المشرق القديم ــ 2
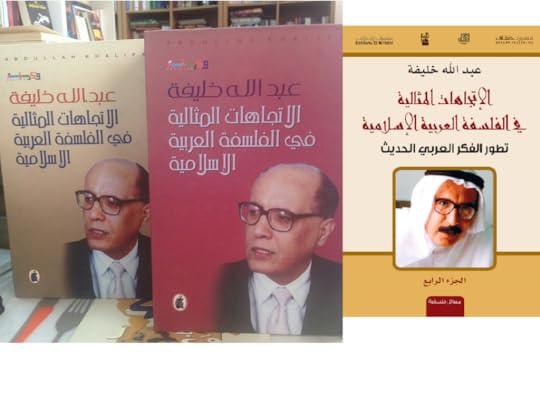 الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية
الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية 2 ـــ الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية
تطور الوعي الديني في المشرق القديم ــ 2
يعالج هذه الفصل قضية تطور الوعي الديني في المشرق القديم الذي صار فيما بعد عربياً، وهي تتناول جوانب البُنى الاجتماعية ومستوياتها الفكرية وظروفها الجغرافية عبر تداخل يكشف نمو هذا الوعي بسياقه البشري.
8 ـ الدين كوعي ( وطني ) متباين
يغدو الدين كفكرة مصاغة من قبل القوة الاجتماعية العليا فكرة قبلية و(مدنية) ووطنية ، لأنه كشكل للوعي لم ينفصل عن وعي الجماعة ، لكن يُلاحظ الفرق الكبير بين الدين في المشاعية والدين في المجتمع المنقسم اجتماعياً ، حيث كانت سمات الأمومية والخصوبة والتعاون تظلل آلهته ، في حين تصاعدت جوانب القوة والعنف والهيمنة مع آلهة النظام الطبقي ، مما يعبر عن تصاعد دور الدولة كجهاز قسر وتحكم.
وفي الفترة الأكادية التي يظهر فيها عنف الألوهية وشراستها ، تبدو كمرحلة مختلفة عن ألوهية العصر الأمومي الخصوبية ، وعن المرحلة اللاحقة وهي التي ستنمو بالتضاد مع آلهة الساميين الرعويين الباطشة ، والتي تغدو تركيباً من مرحلة الأمومية وصعود الإله الذكر المعبر عن مرحلة الدولة والطبقات ، في توليفة متجاوزة للعهد (السامي الأكادي) وسيكون ذلك تجميعاً مشرقياً ، وإن كان بصورة متفرقة ، لإله الخصوبة وقد صار ذكراً ، وتجلت فيه فعل الطبقات المقهورة كذلك ، بعد أن كانت الصياغة الأساسية في المجتمع المشرقي الطبقي ، من فعل الطبقات القاهرة.
لكن فعل هذه الطبقات المقهورة يتجلى من خلال إرثها الزراعي ، حيث تتشكل الآلهة المقاومة المعَّذبة المتمزقة ، وهو ما يعكس تغييب الفعل البشري في الطبيعة ، وجعل ذلك في رموز متفردة مفارقة في نهاية المطاف ، تزيل ملامح ما هو سياسي واجتماعي .
إن الدين لا يعبر فقط عن القاهرين بل عن المقهورين أيضاً ، فالطبقات المتعددة ترى الإرث الديني بصور مختلفة ، وقد عكست المرحلة التموزية على سبيل المثال ، فعل الطبقات الشعبية ، خلافاً للعصر السابق ، ولكن القوة المسيطرة تقوم دائماً بالتسلل إلى البنية الدينية التي غدت شعبية فتوظفها لما لم تكن لها بداية ، عبر نزع المضمون النضالي العميق لها ، وتحويلها إلى أشكال عبادية مُفرغة من ذلك المضمون ، ومؤدية إلى التهدئة الاجتماعية والاستسلام.
ولهذا سنجد في الميراث الديني عموماً هاذين الجانبين المتضادين المتداخلين ، جانبي المقاومة والاستسلام ، جانبي الكفاح للتغيير أو تأجيل الأهداف إلى الغيب.
وإذا كان الجمهور ، حسب وضعه التاريخي ، لا يجد سوى المادة الدينية ، فإنه سيقاوم داخل غيبها المموه ، وسوف يكسر بعض المحرمات والمقدسات السابقة ، ويشكل مقدسات جديدة يحرك بها التاريخ المجّمد ، في امتيازات الحكام ، وهذه اللحظة هي التي تنفث حرارة بنقد الظالمين ، فترى إن التاجر لا يدخل من خرم إبرة حسب الإنجيل ، وإن المرابين والمستغلين مدانين وإن للفقراء ملكوتاً قادماً ، وبعدئذٍ حين يكون الدين في موقع تاريخي مختلف ، وتتغير علاقته بالطبقات المتصارعة ، وينتقل من التعبير عن طبقة مستغلة إلى التعبير عن النظام الاجتماعي ، أو عن كل القبائل ، أو عن الوطن كله ، حينئذٍ تتبدل صياغاته وتستقر توجيهاته العامة في شكل تصالحي غامض ، ثم تبدأ الطبقة المسيطرة ، أو الطبقات المسيطرة ، حسب المناطق والدول ، في إعادة تشكيله ونزع مضمونه الثوري الذي تشكل في المرحلة الأولى ، حين كان وليد الطبقات المقهورة.
ولكن عملية إعادة إنتاج الدين لا تتوقف ، فهذا التكييف الفوقي ، يقابله تشكيل تحتي ، والأشكال الخارجية من العبادات التي تحاول الطبقة المسيطرة تحويلها إلى قيد اجتماعي للسيطرة اليومية والأهداف السياسية قد تتحول إلى شكل مضاد الخ..
9 ــ الزراعة كاقتصاد مهيمن
إن مساهمة فرعي الاقتصاد الأساسيين: الزراعة والرعي في تطور المنطقة ، يعتمد على عناصر مختلفة كاستئناس الحيوان وتطور الأدوات المعدنية ، وهذه العوامل كبيرة الأهمية لكون عالم الزراعة سيبقى بلا تطورات جذرية ، في حين إن استئناس الإبل والخيول وجلب المواد الحديدية ، الذي سيكون من مساهمة الأقوام الأكثر بربرية وهم ( الهكسوس ) ، ملوك الرعاة ، والذين جاءوا في منتصف الألف الثاني قبل الميلاد وأحدثوا الكثير من الخراب كذلك ، إن هذا سيؤدي إلى الفعالية الكبيرة للرعاة على حساب المزارعين. إن انتشار الحديد والخيل وتغلغل الإبل في الجزيرة العربية ، سيروض المناطق الأكثر أتساعا وصحراوية في المنطقة ، والتي ستتمتع باستقلالها شبه المطلق ، في منطقتها الصعبة الوعرة، وقد حاول الرومان مرة واحدة غزوها في حملة فأصيبوا بكارثة( 18).
لقد كانت الزراعة وتوابعها: الحرف والتجارة، هي سيدة المنطقة فيما قبل غزو الهكسوس ، لكن القرون التي تلت بدأت تصعد أقوام الرعاة كالآراميين ، الممهدين الأخيرين للعرب جنساً ولغة.
وإذا كانت الزراعة لم تنفصل كلية عن الرعي في حقبها الأولى ، وقد حدث الانفصال حين تمكن الرعاة من استئناس الحيوانات ذات الأهمية القصوى في تطورهم وهي الخيول والإبل ، فإن الرعي لم ينفصل كلية عن الزراعة ، فحين تتواجد الظروف المائية الكافية كان يمكن الجمع بين الاقتصادين ، إلا أن الانفصال الكبير قد حدث ، ووجدت الساحة الأكبر لتطور الرعاة ، وهي الجزيرة العربية ، فيما بعد مجيء الهكسوس.
ويلاحظ أن الممالك العربية الأمومية في شمال الجزيرة العربية ،( 19) ثم الممالك السواحلية المتعددة في اليمن والحجاز والبحرين وعمان ، كانت أقل رعوية من الداخل ، وذلك بسبب نشؤ المدن والزراعة. إلا أن العمق الرعوي هو الذي كان يتحكم في الحركة التاريخية للعرب ، حيث لم تستطع أي مدينة أن تفرض نفسها على الرعاة الأشداء وعبر المنطقة الهائلة الاتساع.
ويمكن ملاحظة بدايات التطور الحضاري لدى العرب الشماليين القيسيين ، في مدائن صالح ولدى المناذرة والغساسنة والأنباط ، وفي الشريط الحضاري للحجاز، والذي تناثرت فيه المدن التعدينية ، حتى جاءت مكة تتويجاً لمخاض اقتصادي واجتماعي طويل ، ( 20).
10ـ الزراعة والفروع الأخرى من الاقتصاد
تشكلت المدن في المشرق من القرية الزراعية ، التي كان المعبد ثم القصر شكلي التطور السياسي الديني المهيمن فيها ، فمن الزراعة في المشرق الخصب تشكلت السلطة السياسية التي سيطرت على خريطة المدن والمجتمع ، ومن خلال فائض الزراعة ثم الحرف والتجارة كانت تتشكل الحياة الاجتماعية والثقافية المختلفة.
إن الزراعة لا تمثل تشكيلة اقتصادية ـ اجتماعية ما ، مثلها مثل الرعي، والحرف ، فهي مهن وعمليات إنتاجية وتوزيعية متعددة ، لكنها كانت حرفة واسعة ، بل المصدر الأساسي للإنتاج ، حيث تواجدت الأنهار الكبري ، وأنتجت أوسع الحقول الزراعية. وقد هيمنت الدولة هيمنة مطلقة ، بسبب ما رأيناه من صعود سريع للأجهزة الاقتصادية والسياسية ، فخضعت الحرف والتجارة للتطورات الزراعية مستفيدة من فيضها ومؤثرة عليها بن ، إلا أنهما خضعتا لتطورها في النتيجة النهائية ، فعلى طريقة توزيع الفائض الزراعي يتحدد التطور الحرفي والتجاري.
لقد كانت الطبقة المسيطرة تستلم الفائض الزراعي بصورة عينية أو بصورة ـ عينية نقدية ، ثم تركزت الفوائض بشكل نقدي شبه كلي في سيرورة التاريخ ، حيث يمكن تحويل النقد إلى أي بضاعة أخرى. وعبر هذا الاستلام تتكون مؤسسات الدولة ، فهي ليست سوى خزانة لتراكم استغلال الفلاحين ، وبعد الخزانة تتشكل المؤسسات التي تقوم بحسابها أو الدفاع العسكري عنها.
ولا تلعب التجارة والحرف دوراً مستقلاً في تطوير الاقتصاد ، فهما مربوطتان بفوائض الزراعة ، التي تتحكم بها الخزينة الملكية ، والتي تغدو مشروعاتها الاقتصادية والاجتماعية رهن بذاتية الحاكم المطلق ، أي بأسباب مرحلته ، وأسرته ، ورغباته ، وأفكاره ، وسنه الخ..
وهكذا فإن الزراعة التابعة للطبيعة تبعية شبه مطلقة ، ستهيمن على الحرف والتجارة من خلال تحكم الأسرة الحاكمة أو القصر ، مما يلحق هاتين المهنتين كذلك بالتبعية للطبيعة و” أقدارها “. وكأن كل شيء سيتعلق بالحاكم المطلق ” الإله “.
إن ذاتية الحاكم لا تنفصل عن طبقته ، ومرحلتها وصراعاتها ، وهي لا تلعب دورها الحاسم إلا من خلال هذه العوامل الموضوعية. وإذا كان الحاكم قد توحد بالإله ، وغدا جزءً منه ، أو امتدادا أسرياً ، أو تجسيدا نورانياً له ، فما ذلك إلا شكلاً للسيطرة الشاملة للحاكم على المدينة و(الرعايا) ، أو المملكة ، أو الإمبراطورية الخ ..
إن التجارة بالتحاقها بالقصر تكون قد فقدت قدرتها على تفكيك الملكية الزراعية العامة الشاملة. فرأس المال الكبير لا ينمو إلا عبر الأرباح المتراكمة وهي التي ستأتي من التجارة بالمواد الهامة والثمينة التي يستعملها القصر ، ثم القصور الملكية المتعددة ، ومن ثم بذخ الطبقة الحاكمة كلها من وزراء ورجال دين وتجار كبار الخ.. ولهذا فإن رأس المال لا يتعامل علمياً بالحرف وأدواتها وآلاتها إلا إذا كانت ستلعب دوراً في إنشاء قصر أو عمل مركز رصد للحاكم أو قبر الخ .. ولهذا فإن العلوم ستغدو مجموعات من المعارف المُفككة ، وليست مناهج علمية تغربل المعلومات المختلفة وتنميها.
11 ــ نمو الرعي في الجزيرة العربية
وإذا كانت الزراعة هي أساس تشكيل الفائض الاقتصادي الأساسي وتوزيعه ، في المناطق الحضرية النهرية ، فإن الرعي هو أساس تشكيل الفائض الاقتصادي الأساسي في المناطق الصحراوية . ورغم أن الفوائض هنا قليلة ومحدودة ، إلا أنها تظهر وتتدفق على المدن والأسواق . فالرعي لن يكون سوى ملحق أخير باقتصاد المدينة ، حيث يسيطر الحاكم المطلق ، وسيقوم بتبادل سلعه التي ينتجها من قطعانه مستبدلاً بها السلع الضرورية كالمواد الغذائية والملبوسات والأسلحة. ولن تلعب هذه الفوائض دورها إلا في المدن الصحراوية والقرى ، التي ستمد الرعاة بالوسائل التي تجعلهم يتغلغلون أكثر وأكثر في الصحراء ، وخاصة رعاة الإبل ، الذين عبرهم ستتم عملية الانتشار الأوسع في الصحراء ، وخلق القبائل الأشد فقراً وتوحشاً. وسيبدو هؤلاء الرعاة الجماعات الأكثر تضاداً مع بذخ المدينة ومراكزها الكبيرة خاصة .
وكلما أنتشر هؤلاء الرعاة ، احتاجوا إلى المزيد من الأبناء الرجال ، فتتسع قبائلهم ويشتد الفقر في مستوياتها التحتية ، في حين ينفصل رؤساء القبائل والعشائر ، ويكونون أرستقراطية خاصة ، تشكل مصدراً آخر لاستغلال الرعاة ، ويستطيع هؤلاء الزعماء أن يحولوا القبائل إلى شرطة سياسية وعسكرية واقتصادية للدول التي تريد خدماتها ، أو لخفر قوافل التجارة ، أو إنهم يتحولون بأنفسهم إلى لصوص وقطاع طرق فيشنون الغارات على القبائل الأخرى أو المدن العامرة بالثراء.
لكن لحمة القبائل لا تتفكك مهما كانت عمليات التخلخل الاجتماعي داخلها ، ومهما ظهر الصعاليك والمتمردون ، ومهما أستغلهم رؤساؤهم ، فالوحدة القبلية أقرب للتكوين البيولوجي منها بالتكوين الاجتماعي ، فهي التي تكونت وتحجرت في الصحراء وقاست وصمدت لقسوتها. إن القبيلة تغدو هي الرحم الطبيعي للفرد ، ولهذا فإن القبائل عبر هذه الوحدة الصخرية تغدو قوى اجتماعية كبيرة منظمة في مواجهة مدن مستغلة ومفككة.
إن القبيلة هي أشبه بوحدة عسكرية متنقلة ، قادرة على الترحال والصمود في أقسى الظروف المناخية والاقتصادية ، وهي قوة موحدة وقتالية جاهزة ، وتمتلك مواردها واستقلالها الروحي والمادي ، وهي لهذا تصبح قوة مؤثرة في مواجهة المدينة ذات المصالح المتباينة ، خاصة عندما تبدأ مؤسسات المدينة في التفكك والضعف . وتصبح الأمور أشد خطراً حين تتآلف القبائل وتتحالف ، وتكون قبيلة كبرى.
12 ــ ظهور الرعاة على المسرح التاريخي
وقد تباينت التطورات الدينية بين القسمين الحضاري الزراعي والرعوي الجنوبي ، مثـلما حدث الانقسام الاقتصادي بين الجانبين ، ولكن التكوينين لم يكونا متضادين بشكل مطلق ، فالجانب الرعوي والذي يمكن أن يتحول إلى قرى ، أو قد يسكن المدن فيتحضر ، يتأثر بمنتجات المدن المادية والروحية ، لكن هناك تباينات واسعة مع ذلك ، فنحن نجد الهكسوس في احتلالهم لمصر يعبدون الإله الشيطاني فيها( ست) ، متوجهين إلى شبه توحيد ، رافضين شبكة الآلهة المصرية المعبرة عن حشود من العالم الزراعي المسالم ، وظهر التوحيد اليهودي بعد الانقلاب التوحيدي الاخناتوني ليعبر عن حلم هؤلاء الرعاة المشردين بتكوين دولة.
هنا نجد مثالاً ملموساً حول تضادات الأمم الرعوية والزراعية ، فالقبائل اليهودية عبر توحيدها ، تحاول أن تشكل سلطة سياسية وفكرية داخلها أولاً عبر الالتفاف حول إلهها (يهوه) ، رغم إنها لم تستطع بعد أن تتخلص من عبادتها لأيل الإله الكنعاني ، وهو الصيغة الأخرى لآن الرافدي ، الإله المتعالي الذي لم ينفصل كلياً عن بقية الآلهة المتشكلة في مناخ الخصب ، فهو إله المدينة ــ الدولة، التي رأينا كيف ظهرت بالهيمنة على الملكية العامة الزراعية.أما يهوه فهو إله المدينة التي لم تتشكل بعد ، أي إله الرعاة الحالمين بتشكيل دولة. وحين قام الإله بذلك عبر تشكل الدولة ومؤسساتها ، نجد التوراة تشكو من ملوك إسرائيل الذين لم ينفصلوا كلياً عن أيل وعن تقاليد المشرق (العربي) ذات التعدد الإلهي.
فقد عاد الإله الرعوي إلى منطقة أيل ذات الخصب الزراعي .
إن ظهور اليهود والعرب على مسرح التاريخ في المنطقة أحد المؤشرات على صعود دور الرعاة . وصحيح أن الرعاة كانوا قد ظهروا عبر عمليات الهجوم والاكتساح من قبل الهكسوس و” الكاسيين” ، والعديد من المؤرخين والباحثين يقول بأن اليهود والعرب هم من هؤلاء الغزاة ، (21) ، إلا أنه لأول مرة نجد الرعاة كجسم اجتماعي وسياسي مستقل ، وينبثق من داخل تكوين المنطقة ، أي من مفرداتها الثقافية.
وتتمكن القبائل اليهودية من تكوين دولتين مستقلتين بعد قرون ، إلا أن الدولتين اليهوديتين المقامتين لا تفلحان في الصمود على مسرح المنطقة ، بسبب وقوعهما بين الدولتين الكبريين الرافدية والمصرية ، أساس الكيان الاستبدادي الراسخ في المشرق.
هنا نجد الإله الرعوي يتحول إلى إله دولة ، دون أن يستطيع الإفلات من تقاليد المنطقة لقد أوضحنا كيف انبثقت الدولة ـ المدينة في المنطقة الزراعية عبر نماذج العراق وسوريا ، مما مثـل وحدة صراعية بين الإله المتعالي الذكوري المسيطر وبقية الآلهة الذكورية والأنثوية ، فهذه الوحدة يشدها قطبان دولة مسيطرة متعالية واقتصاد زراعي بتقاليده الأسطورية ، مما يمنع الأنفكاك بين قطبيها. إن آنو لا ينفصل عن تموز ، وآيل لا يلغي بعل. ورع لا يزيل أوزوريس.
ومشكلة الإله يهوه إنه يحاول أن يلغي أيل بعد أن جثم في موقعه ، لكون التميز اليهودي ومشروع احتلال فلسطين يصطدم بتواجد هذا الإله . وليس هذا فحسب بل أن كراهيته لبعل أشد ، حيث تتجسد التقاليد الطقوسية الفلاحية. وهو إله يسعى في ذله الطويل أن يعوض عن هذا الاستعباد والدونية ، دون أن يمتلك القدرات البشرية والمادية الكافية لكرامته. ولا تفعل سلسلة الأنبياء والمعجزات في تصعيد التكوين السياسي الزراعية ، وفيما بعد ، في عهد الأسر البابلي يعتبر ذلك التداخل هو سبب الكوارث والنكبات التي حلت على بني إسرائيل ، دون أن يخطر بباله إن وقوعه على طريق مرور الإمبراطوريات ، ومحاولته التميز والتفرد الإلهي بقدرته البشرية القليلة في ذلك المكان هي أ سباب كوارثه المتلاحقة.
13 ـ تناقضات يهوه
هكذا رأينا الإله الرعوي محملاً بالبروق والرعود ، أي بعناصر القوة الرمزية، وهو يخرج من مصر بتقاليدها الزراعية ، داخلاً في منطقة زراعية أخرى ، فلا يستطيع الإنفكاك من شريط العالم الأخضر بتقاليده الطقوسية ، إلا عبر تكريس نفسه في العزلة ، والعيش في الصحراء ، واستثارة التقاليد الحربية حتى يقتحم الأرض (الموعودة). إن هذا الحراك الرعوي أنتج الإله شبه المجرد ، رغم إن المرحلة الفكرية للشعب(المختار) لم تكن قادرة على تجسيد الإله إلا بشكل حسي . فالرعاة مثلهم مثل الفلاحين ، لا يستطيعون الوصول إلى التجريد ، خاصة وإن الإله المجرد غير ممكن تشكيله في المرحلة الدينية الأولى في المشرق ، حيث تتطلب العلاقة بين القائد السياسي(النبي ) والجمهور الأمي ترابطاً قوياً يتيح للقائد تحريك الجسم الرعوي، الذي يتم تدريبه وتوجيهه، لاحتلال المنطقة الزراعية المقصودة.ولهذا فإن تشكيل الإله المجرد أمر غير ممكن وغير مفيد، ومع هذا فإن هذا الإله لا بد أن يكون مختلفاً عن آلهة الأمم المجاورة ، وهي الفضاء الفكري الوحيد المتاح.وهي كلها آلهة مجسدة ومنظورة.
إن المهمات السياسية المطلوبة من نمط الإله ، والمستوى الفكري لحملته المدعوين لتنفيذ تلك المهمات ، هي التي تجعل صورة الإله اليهودي تنوس بين التجريد والملموسية ، بين أيل وبعل. إن هذه الانفصالية غير ممكنة للشعب العادي ، وإذ تحدث العملية شبه التجريدية للإله فهي لا تدوم ، سواء إذا غاب النبي لوقت وجيز ، أو إذا أسس خلفاؤه مملكته.
إن الرعاة أنفسهم مرتبطون بالتقاليد الزراعية الأقوى حضوراً حتى ذلك الحين.وهم في ذات الوقت مرتبطون بالفضاء الفكري للمنطقة ، والمتسم بالتجسيم المادي للآلهة ، والتجسيم ليس سوى تعددية للآلهة تعكس تعدد مستويات السلطات في العالم القديم المفكك اقتصادياً ، سواء على مستوى المدن أم الأقاليم أم القبائل أم الأسر ، وكل هذه تخلق آلهة، والآلهة المضادة كذلك وهي الشياطين والعفاريت ، فالأبيض النوراني يخلق الأسود الشرير ، وقد نشأت الدولة الاستبدادية في المشرق عبر تجاوز هذه التقسيمات وعبر السيطرة عليها ، فآن أو أيل يهيمن بشكل علوي ، ويترك شبكة الآلهة الأقل ، أو السلطات المحلية المختلفة، تعمل وتستقل ذاتياً، وهذا ما يتيح الوحدة و التعددية والاختلافات والصراعات بين الآلهة ، مما يشكل إمكانيات للدراما المسرحية والسياسية والفكرية ، مثـل هذا المناخ يمكن أن يبرر الصدامات والتباينات في العالم الأرضي ، الذي هو حسب الوعي السائد ، لا يمتلك إمكانية تشكيل مصائره بنفسه ، بل يعتمد على القدر الإلهي ، وعلى خرق هذا القدر عبر مساعدة آلهة أخرى ، فيمكن رد مختلف تباينات الوضع الإنساني ، إلى اختلافات علوية ما.
إن ألواح القدر التي تكتب وتقدم في بدء موسم احتفالات الخصب في بابل ، معبرة عن مقادير الإنتاج التي يقدمها الناس ، هي التي تحدد مصائر السكان لسنة كاملة غير قابلة للنقض ، وقد يكون في هذه الألواح طوفان أو هجوم أجنبي أو خير عميم ، وفي الواقع فإن الأقدار لا تعرف إلا بعد حصولها ، ومن ثم تكتب لاحقاً ، ولكن هذه الطريقة توضح الحالات التجسيمية التعددية للوعي الديني ، ولكن مع صعود الإله الواحد المسيطر بشكل مطلق على الوجود ، تدريجياً أم دفعة واحدة ، فإن هذه الإمكانيات للصراع والتباين الإلهي ـ البشري تزول ، حيث يغدو الوجود من صنع إله واحد ، ويحدث التساؤل في الوعي الديني التوحيدي عن أسباب الخلل والتناقض في الحياة المخلوقة من صنع إله واحد .
إن الضرورات السياسية في مصر في عهد إخناتون ، حين أراد أن يجهز على سلطة الكهنوت ويمركز السلطة في يديه ، وجهته نحو تعميم عبادة آمون ، مثلما قادت الضرورة القبائل اليهودية إلى إله واحد مخصص لها ، لم يصبح الإله الكوني الوحيد إلا بعد أن تفاقمت الهزائم والكوارث على هذا المشروع السياسي ، فوجه الحاخامات الشعب اليهودي نحو الإله الواحد تجسيداً مطلقاً لحلم زال.
لكن توجيه الأمور نحو ظهور إله واحد لا بد أن يعيد النظر في الإرث الديني التعددي والتجسيمي السابق ، فيزيل كل عوامل الصراع الإلهي ـ السياسي ، ويمركز السلطة في ذات وحيدة ، في سلطة واحدة مطلقة.
إن الفلاسفة فيما بعد سوف يتصارعون بشدة حول هذا الإله الوحيد ، الذي رأينا كيف تتجه صورته إلى التجريد أكثر فأكثر ، نظراً لحاجات الشعوب للمركزة السياسية أو تكوين دولة جديدة ، ولن يعرف هؤلاء الفلاسفة كيف يجمعون بين إله مجرد، وهو أيضاً ذو تدخل وملموسية وحضور مادي ، عبر مناهجهم المجردة واللاتاريخية.
إن الحاجة تدفع لبروز الوعي بإله وحيد مجرد ، لتذويب الوحدات السياسية ـ الاقتصادية المتباينة وتشكيل دولة موحدة ، ولتجمع السلطات بين يديها، ولكن تجميع السلطات في لحظة تاريخية ما لابد أن يقود في لحظة أخرى إلى تفكيك هذه السلطة المركزة ، فتتراوح صورة الإله المجرد بين لحظتين متضادتين: التجريد الأقصى والوحدانية ، وبين التعددية والملموسية المباشرة.
في التجريد الأقصى تقع صورة في العزلة والنأي عن الوجود المادي ويستحيل معرفة كيف تتم العلاقة بين المجرد الكلي والأشياء ، وفي التعددية والملموسية ، تقع صورة الإله في دائرة الامتداد والحركة والتجسيم.
إن الرعاة وهم يريدون تشكيل دولتهم يستعينون بفكرة الإله الوحيد ، تعبيراً عن الرغبة في الدولة الموحَّدة ، وحين يقتحمون البلاد الزراعية ، يريدون الاحتفاظ بهذه الواحدية ، التي يرفضها سكان المناطق الزراعية.
إن صورة الإله الوحيد المطلق تظهر إذن وهي لا تزال في دوائر التجسيم ، لم تصر شيئاً مجرداً ، لكونها تمثـل تطوراً في نمو الأساطير ، وليس نتاج الفكر المجرد. إن الأسطورة العبرية ، وقد تشكلت من رغبة في تشكيل دولة وإله خاص مسلح ، تحتك وتصارع أساطير أمم المشرق(العربي) ، ثم يقوم مثـقفوها بالاستفادة من التراث الرافدي والمصري ، ليغنوا صورة إلههم الفقير روحياً ، والمنتزع من براكين البحر الأحمر ، فيأخذوا من هذا الإرث مسألة الخلق الأول لأبي البشر وقصة نوح وأيوب وغيرها من القصص والعناصر ، وتلغى تعددية الآلهة بما يتوافق مع مركزية السلطة وواحدية الإله. ثم يعود هذا الإرث إلى فلسطين ليبدأ نزاع جديد.
لقد أنتصر الإله الرعوي بإرث المناطق الحضارية ، فعرف العبرانيون كيف يستغلون ثروة أمم المشرق الروحية والمادية ، ودون أن تتشكل الدولة ـ الحلم.
ولكن حين جاء الإغريق ثم الرومان المحتـلون لم يستطع هذا الإله أن يكون أداة مقاومة ، فهو لم يكن موجهاً للأمم الغريبة ( الأغيار ) ، وهو مع تواجده في منطقة الخصب الزراعي ، وقف نائياً ورافضاً تقاليدها وطقوسها الاحتفالية الربيعية ، وهي ذات المكانة المركزية في حياة الفلاحين ، إن عداءه لأيل وبعل ، كان يدفع أمم المشرق لإنتاج وعي جديد يتجاوز الديانات الوثنية من جهة ، والديانة الرعوية الانعزالية اليهودية ، من جهة أخرى.
إن نمو المسيحية من رحم اليهودية لم يحدث إلا بسبب إنتاج اليهودية لصورة لإله غير وثـني ، وهي التي ستكون تجاوزاً للتفتيت السياسي ، ففيها حلم توحيد المشرق ( العربي ) عبر سلطة واحدة ، هي نفي للماضي المتشرذم ، وللهيمنة الأجنبية ، وهي كذلك استعادة لآن وأيل ورع ، وقد تخلصوا من ثيابهم الوطنية ، ولكن المسيحية هي أيضاً تموز وبعل وأدونيس وأوزوريس ، هي الابن الفادي ، والإله الذبيح ، أي هي أيضاً استمرار للاحتفالات الطقسية القديمة ، إرث شعوب المشرق الزراعية الطويل. هكذا يغدو الأب والابن تجاوزاً للمسميات وتوحيداً لها في أسمين عائلين مجردين وعامين ومخصوصين. لكن المسيحية وقد اعتمدت اللاعنف ، وتغلغلت بين الفلاحين وسكان المدن والعبيد ، عجزت عن الوصول لتوحيد سكان المشرق العربي ، مركز الفعل الحضاري في الشرق الأدنى ، وخاصة الأقسام الرعوية الواسعة ، التي أصبحت تمتلك قدرات سكانية كبيرة. ثم دخلت المسيحية في انقسامات وتم استيعابها من قبل الإمبراطورية الرومانية ، فلم تستطع القيام بمهمات توحيد المنطقة و”تحريرها”.
إن الأديان المشرقية : اليهودية والمسيحية والإسلام تمثـل إذن درجات المقاومة المتصاعدة من الحلقة الأقل حضوراً إلى الحلقة الأوسع والأقوى سكاناً.
15 ـ التوحيد العربي
كانت هذه المهمة من نصيب القوم الرعاة وهم العرب ، الذين أتاحت ظروف جزيرتهم العربية ، المحكمة الإغلاق أن يتكاثروا فيها ويتطوروا ، ولا توجد منطقة رعوية بها هذه الخصائص الفريدة ، حيث القرب من المناطق الحضارية المركزية ، واستيعاب منجزاتها ، والنأي أيضاً عن سيطرتها .إن عشرة قرون من الاحتلالات الأجنبية للمشرق الذي أخذت تتشكل فيه جذور للعروبة ، والتي تمتد من عمق الجزيرة حتى بوادي الشام ، لم تظهر فيه قوة محلية قادرة على طرد الغزاة ، وقد أصبحت السيطرتان الرومانية والفارسية عبئاً ثقيلاً على المنطقة ، حيث تذهب الفوائض المالية إلى العاصمتين فتهدرانها في البذخ والحروب ، ولهذا فإن المناطق الرعوية والريفية تعيشان أزمة اقتصادية . ومن المعروف كيف تدهورت حياة أسرة هاشم بن عبد مناف ، وكيف تفاقمت الديون وحياة الفقر في مكة على سبيل المثال.
وقد أخذت الجزيرة العربية منذ زمن بعيد الإرث الثقافي للمشرق ، وخاصة للقبائل والشعوب السامية الشمالية ، وقد كان الاحتكاك بين الجانبين كبيراً وعميقاً على مر التاريخ.
( يبدو أن مفهوم ” آن ” ـ (السيد) ظهر في التاريخ في حوض النهرين الأدنى قبل الألف الرابع ق .م. وظل كصفة للقوة والسلطة المطلقتين اللتين توحي بهما السماء (الله بمفهومنا) مترسخاً في الذهنية الحضارية السورية لأكثر من ألفي سنة. وفي العصور المتأخرة ساد هذا المفهوم أيضاً في العربيتين الشمالية والجنوبية ) ، (22 ).
ويذكر المؤلف في العديد من الصفحات الأماكن التي التصقت بآن وأيل في مختلف أنحاء المشرق كظهران وجيزان وغمران ، أو سعد إيل وتيم إيل (23) .
إن تحرك إيل أو آن نحو المناطق الأشد رعوية كان لا بد أن يؤدي إلى تغيرات في بنيته ، فقد ظهر في عالم المدينة ـ الدولة ذات المحيط الزراعي ، وداخل شبكة من الآلهة المتعددة ، تعبيراً عن الوحدة الصراعية بين الدولة المتعالية والجسم الفلاحي.
لم يحدث الإنفكاك بين صورة الإله المجردة ومحيطه الزراعي إلا في لحظتين سياسيتين ، هما لحظة الإله آتون ولحظة الإله يهوه ، وكلتا اللحظتان تشيران إلى مشروعين سياسيين تحوليين هامين في المنطقة ، فإخناتون حاول الإطاحة بتعددية السلطات الدينية والسياسية ، وتركيزها في يديه ، فواجه الكهنة ولكن لم يستطع أن ينتصر لأسباب تاريخية واجتماعية عميقة ، فتكوين الإله المجرد المفارق كلياً للأرض الاجتماعية الزراعية التي تكون منها ، وظل على علاقة صراعية متداخلة بها ، أمر لم يحدث ولم يتشكل.
إن هذه الإمكانية ممكنة فقط في حالات مخاض العالم الرعوي عن مشروع تكوين سياسي جديد ، ولعل ثمة علاقات بين إخناتون والعالم الرعوي ، أي أن ثمة مواداً مشرقية تغلغلت في الوعي المصري السائد وراحت تحفزه للتوحيد الاجتماعي وتذويب الوحدات الاقتصادية والسياسية والفكرية المفككة ، في تكوين سياسي واحد وصلب . إلا إن هذا يحتاج إلى أساس اجتماعي مختلف ، أي إلى تنام لعلاقات اقتصادية لا تسود فيها الحياة الزراعية. وكان هذا أمراً غير ممكن موضوعياً في مصر.
واللحظة الثانية ، وقد أشرنا إليها سابقاً ، وهي لحظة الإله يهوه ، المنتزع من عالم غير زراعي ، والتي أعطته فترته السياسية التكوينية ، بين المشروع وتجسيده ، إمكانية التجريد والعلو فوق العالم الزراعي وبنيته ، دون أن يتمكن من المفارقة والتجريد الحقيقي ، فظل إلهاً ملموساً لقبائل تريد غزو أرض زراعية ، وحين حكمتها ، لم تستطع إلا أن تتردد بين صورتي الإله المختـلفتين. ولم يصبح هذا الإله مجرداً ومنفصلاً عن البنية الزراعية إلا حين أصبحت الجماعات اليهودية مالية وتجارية ، وانفصلت بشكل كبير عن فلسطين ، وغدت قوة النقود واستغلال الأمم الأخرى هو ما يوحدها.
ونستطيع أن نلاحظ إن ثمة قوة مقاومة للاحتلال الروماني والفارسي عبر هذا الحراك الفكري الذي تشكل من المخاض الاجتماعي السياسي الطويل في المنطقة على مدى عشرة قرون ، فإذا كان اليهود قد جمعوا فسيفساء الوعي الديني وأدلجوه لصالح تجربة القبائل اليهودية لتشكيل وطن أو للعودة إليه ، فإنهم كذلك ناضلوا من أجل الإله الواحد الذي يحاول أن ينسحب من التقاليد الزراعية الوثنية التعددية ، فيدعو للقوة وعسكرة القبائل ، لكن المادة البشرية اليهودية المحدودة لم تكن مؤهلة لخلق الوحدة وطرد الغزاة.
في حين إن المسيحية التي كانت أبنة التطور الفكري والسياسي للمنطقة ، استطاع مثقفون ينتمون للحضارة الإغريقية ـ الرومانية أن يحولوها إلى استجابة فكرية أيديولوجية لحاجات الإمبراطورية الرومانية في التوحيد والتجميع. ومن هنا تغلغلت المسيحية في العالم المسيطر والعالم المسيطر عليه ، في البلد المهيمن والبلدان المهيمن عليها والمنهوبة. ولم يعد ثمة فرق بين من يستغل ويتلقى العذاب ، ومن يقوم بالاستغلال والتعذيب ، عبر مجموعة من الأفكار التي راحت تنمو وتتجير لصالح توليفة من الانسجام والتوفيق بين الأطراف المختلفة المتصارعة ، سواء عبر أفكار تتجاوز اليهودية المحصورة ، أي عبر إلغاء ” الخطيئة ” الأصلية الذي يعني تجاوز اليهودية واستيعابها ، ومن خلال نشر ثـقافة اللاعنف والتسامح ، بحيث يتشكل مخرج تاريخي لنظام العبودية المتعدد الألوان بين الغرب والشرق ، وتستعيد الزراعة دورها التاريخي ويتم تخفيف العبودية الخ .
وهكذا فإن المسيحية عبر تطورها ، الخاضع لهيمنة الثـقافة الإغريقية ـ الرومانية ، انفصمت حينئذٍ عن الحاجات السياسية والاجتماعية الملحة للمشرق ، وغدت وعياً سياسياً يتجه لتغيير بؤرة السلطة في العاصمة السياسية للإمبراطورية. وغدت تخفيفاً من الهدر الإلهي التعددي الوثني وتركيزاً له واختزالاً لبذخه ، فصار انتصار التثـليث موظفاً للحاجات السياسية للإمبراطورية أكثر منه للشعوب ، وخاصة المشرقية ولشعوب شمال أفريقيا المستغلة كذلك ، وسوف يكون تغلغل المسيحية في عالم الغرب الزراعي أكثر منه في عالم المشرق الزراعي ـ الرعوي.
وقد أستمر الغليان المسيحي في المشرق ، مركز إنتاج الفكر الديني ، وظهرت حركات المعارضة المسيحية الكبيرة فيه ، مما يعبر إن صراع المصالح ، صراع الطبقات ، لم توقفه المظلة التسامحية ، وعبرت النسطورية عن مهاجمة قلب العقيدة الرسمية التي شكلتها الدولة ، فألغت التثليث الإلهي ، وهذا ما فعلته الفكرة الآريوسية بإنكار أن يكون المسيح إلهاً.
إن هذه الإنشقاقات الفكرية كانت الشكل الفكري للاستقلال السياسي ، ولكن كما أوضحنا أعلاه ، كان المسيحيون العرب والمشرقيون بلا قوة عسكرية كبيرة ، وكما قلنا كذلك فإن التغيرات الثورية الداخلية كانت شبه مستحيلة للسكان المزارعين والعامة المدنيين ، ومثـلت المسيحية ذاتها شكلاً للتوافق والتصالح والمسالمة.
لقد أخذت الاتجاهات التوحيدية تنمو في الجزيرة العربية ، بسبب المصالح المشتركة لقبائلها العربية ، ولتنامي العلاقات الاقتصادية والفكرية بينها ، وكانت العبادات الوثنية ، التي عبرت عن مصالح مستقلة للقبائل والمناطق ، لم تعد تستجيب لعلاقات التوحيد الاجتماعية والسياسية المتصاعدة.
إن شبكة الإلهة الوثنية عبرت عن مكانة مركزية منهارة للمرأة ، فقد سيطرت الإلهات الأنثى : اللات والعزى ومناة ، على القبيلة الإلهية ، ولكن الإله الذكوري(هبل) كان يتمتع بمكانة خاصة ، غير أن سيطرة الآلهات الأنثويات يمثل تناقضاً كبيراً مع تنامي العلاقات الأبوية الذكورية القوية ، ولم يكن ثمة من المرحلة الأمومية سوى بقايا أسماء ، وكانت كافة أسس الحضارة قد تشكلت بين القبائل المسماة عدنانية ، وهي التي كانت ضاربة في البداوة ، بخلاف القبائل القحطانية التي استقرت في اليمن وكونت دولاً ، غير إنها لم تستطع القيام بالتوحيد السياسي للمنطقة ، لأسباب تتعلق كذلك بالبنية الزراعية المفككة ، وقد ضعفت الزراعة مع انهيار سد مأرب ، وعودة الكثير من القبائل اليمنية للارتحال والبداوة. إن هذا قد وضع كذلك أسساً للتقارب بين التجمعين العربيين الكبيرين ، إلا أن التمايز القبلي سيظل لفترة طويلة.
لقد أدى هذا إلى المزيد من التدهور المعيشي لغالبية السكان ، وأزداد ذلك باستمرار الحروب ، كما أشرنا ، بين الإمبراطوريتين الفارسية والرومانية، وكذلك الحروب الأهلية العربية .
لقد تضخم عدد القبائل الرعوية في الجزيرة ، وأصبح العدنانيون (القيسيون) القوة الكبرى فيها ، وتشكلت لهم مدن هامة ، خاصة مكة التي أخذت تلعب دوراً توحيدياً تجميعياً ، وكان موقعهم المتميز الواسع في الشمال والغرب قد جعلهم قادرين على توحيد الجزيرة وقبائلها.
كيف كانت استجابة الوعي الديني للعمليات الاقتصادية والاجتماعية التوحيدية ؟
بطبيعة الحال كان العرب في وضع استقبال طويل للمؤثرات العربية الشمالية خاصة ، حيث كان التداخل والتفاعل الطويل.
( في أوغاريت ، ومنذ الألف الرابع قبل الميلاد ، قام أتباع إيل وبشكل حاسم ، بإلغاء كل حضور للأرباب من الطقوس الدينية للبلاد ، فبعل أقوى الأرباب الأوغارتيين ، صار الآن شيطاناً أكبر ، وزعيماً للأبالسة ، وكذلك عشتار التي أصبحت علة للانحلال الخلقي ومصدراً للإباحية الجنسية. ) ، (24 ).
إن حصول الصراع بين أتباع أيل وبعل ، بين الإله الممثل للسلطة العليا ، وآلهة البنية الزراعية ، هو ظاهرة أخذت تتنامى في المنطقة الشمالية من المشرق ، بسبب تصاعد العمليات التوحيدية السياسية ، وبسبب تدفق الرعاة المستمر ، الذين أخذوا يجعلون المنطقة بدوية أكثر فأكثر. كذلك فإن مهمة توحيد المنطقة وطرد الغزاة ، كانت تنمو عبر القرون. لكن هذا الصراع ظل مستمراً دون حسم بسبب التداخل بين البنيتين الرعوية والزراعية ، وعدم قدرة المؤسسات السياسية على الانفصال الكلي عن الجمهور.
لقد رأينا كيف توغلت الآلهة الشمالية في الجزيرة العربية ، وكان إندغام أسمي أيل وآن بمناطقها ومدنها وأسماء البشر والآلهة فيها مؤشر على الترابط والتلاحم بين الجزئين العربيين ، ولكن تطور مكانة أيل خاصة ، يعبر عن النفوذ الفكري المتزايد للشمال السوري مثلما أخذت البادية السورية تصبح امتداداً لتدفق الرعاة من الجنوب.
( لاحظ جورجي كنعان في كتابه ( تاريخ الله) أن النقوش التي عثر عليها في الإمارات الآرامية تتضمن إشارات واضحة إلى التطور الذي لحق باللفظ ( إيل ) منذ الألف الأول ق. م . من حيث البنية والمدلول ، فمن حيث البنية ترددت في النقوش صيغ متعددة ل ” إيل ” مثل (ال ه ) ، ( ال ها ) ، ( ال هه ) ، (ال هم) ، ( اله ى ا ) . ومن حيث المدلول تحولت الصفة ( إيل ) عند العرب القدماء إلى لفظة (الله ) فكان من الطبيعي أن يدخلوه في تركيب أسمائهم مثل : ماء الله ـ سعد الله ـ الخ ) ، (25 ).
وفي اليمامة كانت عبادة (الرحمن) منتشرة ، وهو أسم يجمع بين الرحم ، وهو صلة القرابة المقدسة ، والإله آن .
لا نستطيع أن نقول إن إيل قد تخلص من الآلهة الزراعية ، وصار تجريداً كاملاً ، فالبقع الزراعية قد شهدت الاحتفالات الطقوسية الاخصابية ، وقد كانت جذور الحج الوثني إلى مكة تحمل سمات ذلك ، عبر شرب الخمور ولبس ملابس قليلة وتقديم الذبائح إلى الأصنام.
لكن ضخامة الجسم العربي الرعوي ، وضآلة المناطق الزراعية ، وعملية التوحيد المستمرة في بنية الجزيرة العربية ، والدور القيادي المكي في ذلك ، جعلت عملية التجريد الواسعة تكبر في رمز الله ، نفياً للإلهة الأنثى الملحقة به وهي (اللات) ، تعبيراً عن الانفصال الحضاري الكامل عن المجتمع الأمومي ، ولكافة شبكة الآلهة المفتتة للجسم الاجتماعي ، و تعبيراً عن تشكل المؤسسات السياسية الحاكمة وصعود الحاكم الفرد كذلك ، والانتقال إلى الحضارة.
هنا حدثت عملية التجريد الثالثة دون صعوبات هائلة كما حدث في عمليتي آمون ويهوه ، بسبب محدودية الإرث الزراعي وطقوسه ، والدور الكبير الذي تلعبه القبائل الرعوية ، فغدت عملية التوحيد الدينية والسياسية عسكرة لهذا القبائل وتوجيهها نحو التوسع وتغيير طابع المنطقة وطرد القوى الأجنبية منها وإحداث عملية تقدم حضارية كبرى بها.
المصادر :
(1 ) :(راجع : تاريخ الشرق الأدنى القديم ، د. محمد أبو المحاسن عصفور ، دار النهضة العربية1984، بيروت ص 60 ــ 62).
( 2) : ( فبما أن البشر قد خلقوا لخدمة الألوهة (…) فان كل مدينة دولة قد كانت استثمارة للألوهة خاصة ببنية قرابية (مجتمع ) مخصوصة ، ومكرسة للألوهة المطلقة في شخص أحد أرباب الكون المخلوق ) ( الميراث العظيم ، أحمد يوسف داود ، سلسلة القسام الفكرية ،1991 دار المستقبل ، دمشق ، ص302).
( 3 ) : حول هذه المدينة المسيطرة على الفضاء التاريخي نقرأ: ( مساحة المدينة ميلاً مربعاً ، وبساتينها ميلاً مربعاً آخر ،/ وتبلغ حفر الطين ميلاً مربعاً ، وكذلك أرض الفلاة المحيطة بمعبد عشتار . ثلاثة أميال مربعة ومساحة من أرض الفلاة تكون مدينة أوروك ) ( ملحمة جلجامش ، من كتاب ” أساطير من بلاد الرافدين ، ترجمة نجوى نصر ، دار بيسان،1997، ط . 1 ) .
(4 ): ( جذور الاستبداد ، عبد الغفار مكاوي ،عالم المعرفة ، العدد192 ، ص59، الكويت ).
(5 ) : إن هذه البنية الاقتصادية ـ الاجتماعية هي أساس النظام ، في حين تتبدل الهياكل السياسية دون مس كبير لأسس البنية ، يقول مؤلف كتاب (الميراث العظيم) حول تجربة مصر: (لكن وجود الدولة المركزية لم يكن يعني ـ على ما يبدو ـ تغيير الشيء الكثير في جوهر التركيب الجمعي وحتى الإداري . فقد ظلت المدينة ـ الدولة أساساً في تكوين الدولة القطرية ، وهو ما تتكشف عنه متابعة الدراسات المكتوبة في تاريخ مصر القديمة.) ، ( الميراث العظيم ، ص 299.).
( 6 )  مغامرة العقل الأولى ، فرس السواح ، دار علاء الدين ، ط10 ، ص31 .) .
مغامرة العقل الأولى ، فرس السواح ، دار علاء الدين ، ط10 ، ص31 .) .
( 7 )  المصدر السابق صفحات:32 ، 33 ).
المصدر السابق صفحات:32 ، 33 ).
( 8 )  راجع كذلك المصدر السابق، ص94 ـ 97 ).
راجع كذلك المصدر السابق، ص94 ـ 97 ).
( 9 )  المصدر السابق ، ص 39 ).
المصدر السابق ، ص 39 ).
( 10 ) : أساطير من بلاد الرافدين، دار بـيسان، ترجمة د. نجوى نصر ،1991 ، ص 124 ) .
( 10)  الإسلام وملحمة الخلق والأسطورة ، تركي علي الربيعو . المركز الثقافي العربي ، ط1 ،1992 ، ص114 . ).
الإسلام وملحمة الخلق والأسطورة ، تركي علي الربيعو . المركز الثقافي العربي ، ط1 ،1992 ، ص114 . ).
( 11 )  المصدر السابق ، ص 115.).
المصدر السابق ، ص 115.).
(12 ):( المصدر السابق ، ص 119. ).
(14) ( يقترب أبن خلدون من رؤية تاريخ المنطقة وهيمنة القوى الرعوية فيها في كلامه عن ضرورة الاعتبار لما:(وقع في العرب لما انقرض ملك عاد قام به من بعدهم إخوانهم من ثمود ومن بعدهم إخوانهم العمالقة ومن بعدهم إخوانهم من حمير ومن بعدهم إخوانهم التبابعة من حمير أيضاً ومن بعدهم الإذواء كذلك جاءت الدولة لمضر وكذا الفرس لما أنقرض أمر الكينية ملك بعدهم الساسانية حتى تأذن الله بانقراضهم أجمع بالإسلام وكذا اليونانيون أنقرض أمرهم وأنتقل إلى إخوانهم من الروم وكذا البربر بالمغرب الخ ..) ، (المقدمة ، فصل في الملك إذا ذهب عن بعض الشعوب من أمة فلا بد من عوده إلى شعب آخر منها ما دامت العصبية ، 116، طبعة دار العودة).
(15 ):( جذور الاستبداد، ص168).
(16 ): ( وكان طبيعياً أن يصنع خيال الحكماء الشعبيين في وقت المحنة والظلم ، إلهاً يشاركهم محنتهم ومظلمتهم ، فيموت جوراً ، كما يموت المسخرون حول الأهرامات العتيدة ، وتنطبع الأسطورة الجديدة بطابع جديد على الفكر المصري ، فتحول همها إلى الفقراء ، ومشاكل العوز والحاجة ، وآمال الضعفاء وطموحاتهم ، وتصور الحل الأمثل لهذا الوضع الاجتماعي المختل ، لتصبح الأوزيرية هي التعبير الأيديولوجي عن الثورة الشعبية) ، ( أوزيريس وعقيدة الخلود في مصر القديمة ، سيد محمود القمني ، كتاب الفكر ط 1 ، 1988 ، ص144.).
(17 ) : ( تاريخ جهنم ، جورج بنوا، منشورات عويدات ، ط 1 ، بيروت).
(18 ) : ( المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، د. جواد علي ، الجزء الثاني ، الفصل الثامن عشر : العرب والرومان ).
19 ): ( أشارت تلك النصوص الرافدية ، المدونة في القرن التاسع قبل الميلاد ، إلى ملكات عربيات ..) ، كتاب ( رب الزمان ، سيد محمود القمني ، الناشر مدبولي الصغير ، الطبعة الأولى ، ص 194).
(20 ):(النبي موسى وآخر أيام تل العمارنة ، سيد القمني ، المركز المصري لبحوث الحضارة ، الجزء الثاني ، ص 238).
(21 ) : ( يقول لويس عوض في كتابه( فقه اللغة العربية) : ( ولا شك أن العرب حين نزلوا شبه الجزيرة العربية إنما نزلوا على سكان أصليين كانوا فيها من قبل ، كان منهم العماليق الذين نعرف من قصة ” الخروج ” في التوراة أنهم كانوا مستقرين من الحجاز إلى جنوب فلسطين من قبل خروج بني إسرائيل وهؤلاء أستطعنا تحديدهم بجحافل الهكسوس المطرودين من مصر في القرن الخامس عشر ق. م.) ، (سينا للنشر ، ط1 ، ص52 . ).
( 22): ( تاريخ الله : إيل ـ العالي ، جورجي كعان ، بيسان للنشر والتوزيع ، بيروت ، ط 2 ، ص 179.).
(23 ): (راجع الصفحات180 ــ 204 من المصدر السابق).
(24 ): ( فرس السواح ، لغز عشتار ، ص349).
(25 ):( الأحناف ، عماد الصباغ ، دار الحصاد ، ط 1 ، ص 26).
عبـــــــدالله خلــــــــيفة: تطور الوعي الديني في المشرق القديم ــ 1
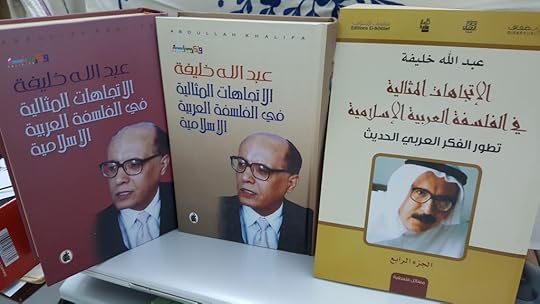 الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية
الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية 1 ــ الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية
تطور الوعي الديني في المشرق القديم ــ 1
يعالج هذه الفصل قضية تطور الوعي الديني في المشرق القديم الذي صار فيما بعد عربياً، وهي تتناول جوانب البُنى الاجتماعية ومستوياتها الفكرية وظروفها الجغرافية عبر تداخل يكشف نمو هذا الوعي بسياقه البشري.
1 ـ جذور الصراع
لقد حدث الاستقرار الزراعي في منطقة المشرق بعد العصور الحجرية القديمة والمتوسطة ، التي كان الناس فيها صيادين وجامعي ثمار ، وفي العصر الحجري الحديث ، وفي قمته ، بدأ الانقلاب الزراعي ، ونجد في الحضارة ( التاسية ) المصرية الشكل المزاوج بين الصيد والزراعة ، وفي حضارة (البداري) ، المصرية كذلك ، حدث الشكل الزراعي المكتمل ، فظهرت القرية الزراعية ، ( 1 ) .
من هذه القرية الزراعية الأولى تطورت المدينة المهيمنة على بقعة زراعية ما ، وظهرت فيها دولة المدينة ، وتشكلت السلطة الأولى في المعبد الديني التي يبرز فيها الكاهن أو الساحر. لقد كان لهيمنة المعبد على الإنتاج دورها في التضفير بين الدين والدولة ، وفي السيطرة المركزية في دولة المدينة. إن ازدواجية دور الكاهن ـ الحاكم ، أو الساحر ـ الملك ، يضفي سيطرة شاملة من قبل الدولة على المدينة من خلال الدين . والحقيقة إن الآلهة ليست هي التي تحكم المدينة حقيقة ، ولكنه الساحر ـ الحاكم أو الملك ـ الكاهن ، ولكن السحرة والكهنة لا يحكمون إلا من خلال هذه الميثولوجيا ، فهذه الأساطير هي التي تبقى دائمة ، ويتم عبرها تشكيل السيطرة السياسية المتحولة الملموسة. إن الملوك والكهنة في المدينة وهم يسيطرون على المعبد ، مركز الملكية الإنتاجية العامة ، يسيطرون كذلك على إنتاج الوعي وخطوطه العريضة .(2).
ومن المؤكد إن ثمة جذوراً عميقة وبعيدة لهذه السيطرة ، في الملكية المشاعية وفي الأدوار الهامة التي تلعبها العناصر المثـقفة ، والتي هي من ثمار الانقسام بين العمل الذهني والعمل اليدوي ، وهي التي ستشكل المدخل للانقسام الاجتماعي بين المالكين والعاملين ، فالسحرة والملوك وإداريو المعابد ، وهم يسيطرون على إدارة المعابد يمثـلون هذه القوى الذهنية وقد بدأت بالتحكم في العمل اليدوي والخيرات التي ينتجها. إن الانقسامات الاجتماعية الأخرى تبقى متوارية ، فالانقسام بين الرعاة والمزارعين لا يتضح هنا ، لكون القبيلة التي انتقلت إلى الزراعة بدأت ذلك من زمن موغل في القدم ، ويعتمد الأمر على إنتاجية الزراعة الهامة المركزية في هذه الحقبة ، وكون الرعي يظل مهنة صعبة وملحقة بالقرية أو المدينة .(3).
وهذه السيطرة المتوارية للزراعة على الرعي ، تغدو سيطرة واضحة متصاعدة للرجال على النساء ، عبر هذا الانقلاب الذكوري المستمر . لكن في قلب الانقلاب يظهر العنصر المثقف والسياسي ، يظهر العمل الفكري وهو يسيطر على العمل اليدوي ، مثلما تتركز السلطة الروحية والسياسية تدريجياً في نموذج وحيد في دولة المدينة.
إن الإنفكاك الذي حدث في صيغة الكاهن ـ الملك ، باتجاه هيمنة الملك ، تعود إلى تنامي أجهزة الدولة ، وأتساع مهماتها ، من إدارة الدفاع وشن الحروب وتوسع الدولة ـ المدينة ، فالصرف المستمر على الطبقة المسيطرة المتشكلة حديثاً ، أو قديماً ، يتطلب التوسع في الأراضي المملوكة للمعبد ، وسيكون هذا قانون من قوانين التطور والهلاك في المدينة ـ الدولة المسيطرة . فهذا التوسع يتطلب النمو المتواصل للقوى العسكرية، وسيعتمد ذلك على حجم القبيلة أو القبائل المستقرة ، ويؤدي إلى ضم مناطق الجيران وإلحاق المناطق الرعوية أو الزراعية بسيطرة المدينة ـ الدولة ، مما يقود إلى أتساع الموارد والسوق التجارية ، وهذا يؤدي إلى المركزة في إدارة الدولة السياسية ، وتغلب الملك على الكاهن ، وصيرورة الكاهن ملكاً ، والملك كاهناً . لكنه يؤدي من جهة أخرى ، إلى الاصطدام بالجيران وقيام المناطق الأخرى والمدن والقبائل الرعوية بالهجوم على المدينة ـ الدولة ، التي غدت (الكنز) الذي تجمعت فيه تراكمات العمل المحلي والمناطقي ، لتتشكل عملية إعادة توزيع.
إن هذه العمليات الطويلة من الصراع والإنتاج والتراكم تؤدي إلى التوسع المستمر في دولة المدينة نحو التكوين الكبير ، سواء كان على هيئة دولة من عدة مدن ، أو على شكل إمبراطوريات ، تجري فيها هذه العمليات الصراعية التحولية على نطاق المنطقة ، لكن قانون هيمنة القصر ـ المعبد يظل سارياً ، فالقصر هو الذي يهيمن على المعبد ، فالسوق ، فالإنتاج وكافة مظاهر الحياة الأساسية .
وفي الوقت الذي تجري فيه هذه العمليات الصراعية الاجتماعية ، فإن الجانب الديني لا ينفصل عنها ، فهو جزء رئيسي من تكونها ، من حيث إنه نتاج عام لتشكلها وأداة لترابطها ولوعيها بالعمليات الاجتماعية ، فيظهر بأنه هو الذي يصوغ تاريخها ، وليست هي التي تشكله.
( إن الآلهة كانوا يرقبون عن كثب أحداث الساعة وقضاياها البارزة عند قيامهم بالتحديد السنوي لمصير بابل وأهلها ، كما كانوا يؤكدون وجودهم الطاغي في كل مكان ، وتأييدهم أيضاً للنظام السائد وسلطاته المستمدة منهم. ) ،( 4 ) .
ومن الواضح إن الآلهة لم يكونوا يؤكدون ذلك عبر وجودهم المباشر ، بل عبر الأجهزة السياسية والكهنوتية . لقد تم ظهور (مجمع للآلهة ) الذي يباشرون منه سلطاتهم المتعددة ، والمجمع يشير إلى العائلة الملكية الإلهية ، أو القبيلة النوار نية الحاكمة في الأعالي ، وهي ترميز للطبقة الملكية ـ الكهنوتية التي يتمثـل فيها النور والعلو والسيادة . وإذا جئنا إلى قراءتها ، في بعدها الاجتماعي، فالأسرة الإلهية المتعددة المتصارعة المتضامنة ، تشير إلى تعدد المستويات السياسية في المدينة ، فهناك الأسرة الملكية الحاكمة الحقيقية، وهناك الكهنة في المعابد المختلفة والإدارات المختلفة . وإذا كان الرجال قد فرضوا سلطتهم العامة على النساء ، إلا أن النساء متواجدات في الأعمال الزراعية وفي الحياة العامة بقوة ، وهذا ما يشير إليه الحضور الهام للإلهة الأنثويات ، أنآنا، وعشتار ومثيلاتها في المشرق.
لكن ظهور الإله المهيمن في الأسرة الملكية الإلهية يبدو واضحاً في كل تشكل سياسي عام ، بهيمنة ( آنو) وتصاعده المستمر في الميثولوجيا الرافدية ، حيث يشير إلى هذه الوحدة السياسية المتعاظمة في جنوب ووسط العراق . إن أنليل يظل مستمر الوجود معبراً عن عدم الانطفاء للمناطق السومرية النهرية ، كذلك فإن ( مردوخ ) يكبر مع تعاظم نفوذ الدولة البابلية ، وكذلك يتصاعد إله ( أشور ) مع أتساع إمبراطوريتهم.
2 ــ السلطة والمجتمع الزراعي
إن هذه المجمعات من الآلهة تشير كذلك إلى عدم الانصهار في عملية سيطرة دولة المدينة على المدن والمناطق الأخرى ، حيث تقوم بترك السلطات المحلية في سيطرتها ، وتأخذ ( الغنائم أو الأسلاب أو الخراج ) منها ، فتتحول الآلهة المناطقية إلى المجمع العام للآلهة وكتوابع للآلهة الكبرى ، مثـلما يحدث بالنسبة للمناطق التي تغدو مُلحقة بالمدينة ـ المركز ، أو مثـلما يحدث بالنسبة للحكام الإقليميين الذين يغدون ولاة أو نواباً للملك. (5).
إن المدينة ـ الدولة ، حيث الزراعة هي العمل الإنتاجي الأساسي ، وتأتي الحرف والتجارة كمهن مُكملة ، تقوم بإعادة إنتاج نفسها على مستوى دوائر تتسع دوماً ، ملتهمة الدوائر الأخرى دون أن تلغيها ، وهدف العملية الحصول على الفوائض المالية دون أن تحدث عمليات تقدم كبرى في الإنتاج.
فكما أن الحرف الهامة متخصصة في الإنتاج للقصر ، وكما تتبع العمليات الثقافية من تنجيم وفلك وطب حاجات الأرستقراطية المختلفة ، فكذلك تتبع الآلهة تبدلات وأهداف الحكام . وعلينا أن نرى التبدلات الكبرى للآ لهة كحصيلة للصراعات الشاملة غير المرئية في العراق ، بمعنى أن نقرأ أسباب العلو المستمر للإله (آنو) والانطفاء التدريجي للآلهة الأخرى.
لقد أعطى السومريون أولى الملامح والملاحم لكيفية نشؤ الآلهة ، لقد ازدهرت (الثقافة السومرية في الجزء الأسفل من حوض دجلة والفرات وحول الشواطئ العليا للخليج العربي ، منذ مطلع الألف الرابع قبل الميلاد) .(6 ).
وتقول أسطورة الخلق السومرية بأنه في بدء الكون ، لم يكن ثمة أحد سوى الآلهة الأنثوية( نمو) ، وهي المياه الأولى التي أنبثق عنها كل شيء ، وقد أنجبت الآلهة نمو ولداً وبنتاً ، والأول هو (آن) إله السماء المذكر ، والثانية (كي) آلهة الأرض المؤنثة ، وكانا ملتصقين مع بعضهما ، وغير منفصلين عن أمهما ، وتزوج الأخوان وأنجبا ( أنليل ) إله الهواء الذي كان في مساحة ضيقة بينهما ، حتى قام بإبعاد أبيه عن أمه . رفع الأول فصار سماءً ، وبسط الثانية فصارت أرضاً، وكان يعيش في ظلام دامس ، فأنجب أبنه نانا إله القمر ، الذي أنجب بدوره (أوتو) إله الشمس .
ويفسر فرس السواح هذه الأسطورة بشكل طبيعي ، فيقول إنه في البدء لم يكن سوى المياه التي صدر عنها كل شيء وكل حياة ، وفي وسط المياه ظهرت أرضٌ ، متحدة بالسماء ، ومن اتحادهما ظهر الهواء ، ولم يكن القمر السابح في الهواء إلا أبناً له الخ .. ( 7 ) .
لا شك إن التفسيرات الطبيعية والاجتماعية والنفسية التي ساقها المؤلف فرس السواح ( 8 ) ، لها جذورها ، ولكن الآلهة تعبير كذلك عن السلطات المختلفة ، وهنا نجد الأسطورة الدينية تحدد التحولات السياسية التاريخية بين المجتمع الأمومي والمجتمع الذكوري. حيث مثلت الأم ذلك المجتمع الراكد المحدود ، من وجهة نظر صائغي الأسطورة ، وهي التي كانت فيه سيدة الوجود المائي الزراعي ، والمجتمع الأمومي هو الذي شكل الزراعة عند شواطئ الأنهار ، وعبر تراكماته الاقتصادية والبشرية ، أوجد العائلة الأبوية الأولى ، حيث لا تزال الأم قوية فيها ، ولكن الابن شكلّ الانقلاب الذكوري عبر الانفصال عن سلطة الأم والأرض والزراعة فيها ، وعبر الصعود إلى السماء .إن ظهور السماء المنفصلة عن الأرض ، وتشكل السلطة الأولى المفارقة للمنتجين، عبر الإله( آنو)، حيث سيتمترس في الأعالي ، تعبر عن الانقلاب الذكوري القديم الأول ، الذي وضع التمايزات الأولى بين السلطة السياسية والمنتجين المزارعين . لقد كانت السماء في وعي القدماء هي مصدر المطر والنور والهواء ، أي كل ما يغذي الأرض والزراعة ، فهي الأصل في وجود هذه الحياة . ويعبر ذلك عن وعي المهيمنين على المعابد والمدينة ، الكهنة والملوك ، الذين ارتفعوا عن العمل في الأرض ، وصاروا قوة مسيطرة فوقية، أصبحت تتماها والسماء الرفيعة، وتضع السمات ( النورانية ) على وجودها الاجتماعي ، لكنها بعد لم تستطع الانفصال الكلي المطلق عن الأم والمنتجين.
هكذا فإن انبثاق (آنو) يضع الانقسام العام في التاريخ الديني الأسطوري والاجتماعي ، بين السماء والأرض ، بين الرجل والمرأة ، بين المالكين والمنتجين ، بين المسيطرين ذهنياً وسياسياً و العاملين . ولهذا فإن صفات الخلق والنور ستعطى للوعي ، أي للقابضين على إنتاج الفكر والسلطة ، في حين إن صفات المادة والطين والعمل والعبودية ستعطى للمنتجين الماديين.
إن عناصر التضاد بين السماء والأرض ستلعب أدواراً كبرى في مختلف تجليات الوعي الديني ، وستغدو الأرض والمرأة أكثر فأكثر، مصدراً للشر والفساد وتتشكل من طبقات الأرض السفلى مستويات الجحيم الخ ، في حين ستكون السماء مركزاً للنور والقوى المشعة الخيرة والملاذ للأرواح الطاهرة.
إلا إن ذلك كله تعبير عن السلطة السياسية والفكرية والاجتماعية ، وتمركزها في الطبقات العليا ، التي ستعيد إنتاج النور والعلو والسيادة ، عبر المقولات المنتجة في كل عصر ، وهي هنا في العصر السومري المتداخل في فضاء العراق الجنوبي البابلي لاحقاً ، تستعين بمواد الأسطورة في تفسير نشؤ الكون وتشكل السمات الرئيسية للمجتمع .
كذلك تشكل الإله السومري الخاص وهو( أنليل) .إن صعود أنليل مترافق مع تبلور سلطة المدينة ـ الدولة ، الشكل الأولي لظهور السلطة والحضارة في بلاد الرافدين ، ويعبر هذا التواصل بين الأب آنو والابن أنليل عن هذه السيرورة الاجتماعية المتراكمة بين المجتمع الأبوي في انقلابه الأول بالسيطرة على النساء والفضاء الاجتماعي ، وبين تبلور ذلك كسلطة مدنية محددة في الأجيال اللاحقة.
وتقول الأسطورة الشعرية : أنظر إلى نيبور عماد السماء والأرض هي / أنظر إلى نيبور المدينة / ترى أسوارها العالية /.. هناك أنليل فتاها الغض / هناك ننليل فتاتها الشابة/ ) ثم تبدأ الأسطورة في تمجيد الإله المسيطر : ذو العينين البراقتين ، السيد ذو العينين البراقتين / الجبل العظيم ، أنليل الأب../ الراعي ، سيد المصائر ..) .( 9 ) .
لقد تشكلت المدينة كدولة ذات موارد زراعية ومائية وفيرة وتجارة ولها أسوار ويهيمن فيها المعبد والإله الذكوري ذو الأهمية القصوى ( الراعي ، سيد المصائر) التي تقول عنه قصيدة أخرى (أنليل مليكك ، أين مضى؟) . وبهذا فإن الخطوط العريضة بين المستوى الديني والمستوى الاجتماعي التاريخي قد تشكلت ، وصار الوعي وهو يستهدف إجراء العمليات التغييرية ، يعيد إنتاج الأسطورة ، أو إنه يقوم بعملياته التحويلية السياسية ثم يضفي على الأسطورة التغيرات المناسبة لهيمنته.
3 ــ مستويات الغيب المهيمن
تمثـل صيغة التحول السابقة الخلية الأساسية في البنية الاجتماعية للمجتمع الطبقي ، في المشرق ” العربي ” ، كما يظهر في التاريخ المكتوب ، بجانبيه المادي والروحي ، فحيث يغدو الكاهن ـ الملك مهيمناً على المعبد والملكية العامة الزراعية ، فإن الجوانب الثلاثة : السياسية والفكرية والإنتاجية تتداخل ، وتصير نظاماً اجتماعياً يتبادل التأثير بين مستوياته الثلاثة.
إن الملكية الزراعية المعتمدة على الري ، تتطلب تسارع أدوات السلطة لضبط عملية الري في الجنوب العراقي ، الذي بدونه لا تتشكل الزراعة ، مما يؤدي إلى تـنامي الأجهزة العامة ، وإبقائها على الملكية العامة القبلية والقروية ، وتصاعد نفوذ الدولة على المناطق المجاورة ، وجعل إله المدينة يشكل الوحدة الفكرية لأهلها ، ثم يتمدد إلى المدن والمناطق التالية ، فيصعد على الشبكة الواسعة من الآلهة الصغرى المختلفة ، فيبدو الإله وكأنه هو الذي يصنع التطور ، وتبدو الحركة الطبيعية والاجتماعية كنتاج لمجّمع الآلهة ، أي لهذه القبيلة الإلهية الترميزية للوجود البشري القبلي المسيطر في سيرورته التاريخية.
إن الانقسام بين آنو وكي ، بين الإله الذكوري المهيمن والآلهة الأنثوية المهيمن عليها ، يشير إلى التضاد الواسع بين الرجل والمرأة ، بين الإدارة السياسية ـ الدينية والعامة ، متخذاً من المظهر الطبيعي بالتضاد بين السماء والأرض جسده الفكري ، فيتشكل هنا التضاد كذلك بين الغيب والمرئي ، بين التصورات الذهنية المفارقة والحياة ، بشكل أولي وغير تجريدي ، لكون كافة الآلهة تتكون في الملموس ، في التجسيدات المادية والتمثلات البشرية. أي لكون الوعي البشري عند المنتجين الذهنيين والمنتجين اليدويين متقارب ، مثل التقارب الاجتماعي بين الحاكمين والمحكومين.
وإذا كان ثمة غيب سماوي يبرز في الأعالي ، فإن ثمة غيباً يتشكل في طبقات الأرض السفلى ، حيث يغدو هذا الغيب السفلي مسئولاً عن ظاهرات الموت والأمراض والغياب البشري الأرضي ، ويتوحد هذا الغيب الأدنى بالكائنات ” الدنيا ” ، أي بالحشرات والزواحف ، والعديد من الحيوانات التي ترافقت مع الموت.إن الموتى في هذه الحقبة ينزلون إلى طبقات الأرض السفلى حيث ( ويخاطب الرجل العقرب كلكامش الذي يريد النزول إلى عالم الأموات قائلاً: إنه من غير مستحيل ، يا ككامش، لم يعبر أحدٌ مسالك الجبال الوعرة.حتى بعد مسافة اثني عشر فرسخاً يحلك الظلام، ولا يعود هناك نور ) ، ( 10 ) .
وفي الزمن السومري فإن الآلهة الأنثى هي التي تنزل تلك الطبقات السفلى الرهيبة ، مما يؤكد استمرار بقايا المرحلة الأمومية ، معطية دلالة تفسيرية للزمن ولتحولات الطقس ، حيث الغياب والحضور للشمس والقمر والشتاء والربيع ، وفيما بعد سيكون هذا النزول للإله الذكر (تموز) ، معرباً عن التغلغل الذكوري الواسع في المنظومة الإلهية ، وعن توظيف هذا العالم السفلي لتحولات أخرى كبيرة.
إذن فإن الغيب ، المعبر عن سيطرة الطبقة العليا، وسواء كان سماوياً أم أرضياً سفلياً ، هو الذي يمسك بدفة الوجود البشري ، عبر تمثلات المرحلة الراهنة . إن التضاد القصي بين السماء والأرض السفلى ، هو تضاد تجسده الصور الحادة بينهما ، فالأولى لها النور والمطر والهواء ولها الوجود السرمدي ، في حين إن الأخرى تتصف بالظلام والفساد والأمراض . إن الوعي البشري هنا يتمثل تناقض الحياة والموت ، والصحة والمرض ، والربيع والجفاف ، والحلم والواقع الخ .. ولا شك إن هذه التضادات الوجودية والاجتماعية مرتبطة كذلك بالتناقض بين الناس والسلطة ، فالسلطة السياسية والكهنوتية هي الحياة والنور والبقاء الأبدي ، حيث أعطى الملوك لأنفسهم صك التوحد مع الآلهة ، والإلغاء التام للناس ، مثلما يحدث في الحياة السياسية حيث تتصاعد الهيمنة المطلقة للحكام. إن ثمة هوة إذن بين السماء والأرض السفلى . لكن كلتيهما تمتلكان الحضور والسيادة في الوعي الغيبي ، بلونين متضادين ، في حين تبقى الأرض غائبة. وفي التضاد المطلق بين السماء والأرض السفلى ، بين النور الأقصى ، والظلام والمرض والموت يتشكل التضاد بين الإله النوراني الخير والشيطان ممثل الشر، وهذا التضاد الذي سيتطور في إنتاجه عبر ثـقافات شعوب المشرق المتداخلة.
إن هذه الخطوط العريضة لتشكل الدين ستغدو هي الملامح الجوهرية للمراحل اللاحقة. فوجود مدينة تطلع من عماء المياه الأولى ، من الغمر ، ومن الزراعة الأمومية ، ليسود فيها الذكر وقوته العضلية ، ملتحماً بالثور الحيوان الأقدر على شق التربة ، عبر الأدوات المعدنية ، لتتكدس الثروة في المعبد فيديرها الملك الكاهن ، فترسم في السماء الرموز الإلهية لهذا التحول الأرضي . إن هذه المدينة التي تلحق الريف والأقسام الرعوية بسلطانها ، ستعيد إنتاج نفسها في جغرافيا وتاريخ المشرق ، وفي البدء ستكون هذه المدينة مدينة زراعية خارجة من فيض المياه ، وسيشكل هذا وحدة صراعية بين المؤسسة السياسية الصاعدة المتحكمة ، وبين القاعدة السكانية الفلاحية .
إن الجغرافيا الطبيعية أعطت لهذه المدينة مصدراً للثروة ، فتصاعد دور المعبد فيها ، وفي المراحل الجنينية الأولى يحدث التداخل بين الكهانة والملكية ، حتى إذا ازدادت ثروة العمل البشري ، حدث الانفصال بين فئتي الهيمنة السياسية والدينية ، دون أن يُـلغى التداخل ، وبدون أن ينتهي الصراع.
والمدينة ليست مدينة صناعة ، بل مدينة زراعة وتجارة وحرف ، ويلعب القصر (وتابعه المعبد) دور الفاعل الرئيسي في تطورها أو اندثارها ، فمختلف تجليات الإنتاج تُلحق به ، لكونه يسيطر على الملكية العامة ، مثلما يسيطر على الملكية العامة الثقافية ، أي الدين ومنتجاته.
4 ــ صعود التضاد بين الزراعة والرعي
إذا كانت الحرف والتجارة لا تستطيع أن تكون إلا داخل المدينة ، فإن الرعي لابد أن يتشكل وينمو خارج المدينة . وفي البدء أيضاً كانت الزراعة هي أساس تشكل المدينة ، فظهرت المهن الأخرى في أسواقها ومركزها. لكن الرعي أمتلك خاصية تجاوز المدينة وحقولها ، والنمو في البراري. وقد أعطت التطورات الإنتاجية خاصة ، الرعي ، إمكانية الانفصال المستمر عن المدينة والزراعة ، دون القدرة على الإنفكاك الكلي منهما. وعبر ظهور تقسيم العمل والتبادل راحت هذه الأقسام الاقتصادية بالنمو ، كل حسب موقعه من علاقات الإنتاج. لقد تحرر الرعي من الهيمنة المباشرة للسلطة واستغلالها ، رغم عدم قدرته الكلية على الخروج من الاستغلال في عملية التبادل مع هذه المدن.
ومنذ بداية تشكل الإرث الفكري الديني في المنطقة كان هناك استشعار لتشكل التناقض بين الرعي والزراعة ، بين المنتج الرعوي الذي يبدأ بأستنئاس الحيوان والعيش في البراري وصنع سلع خاصة ، وبين المدينة ـ الدولة ذات المحيط الريفي الزراعي ، والتي تغدو دائرة إنتاجية وسياسية متكاملة . إن الرعاة يغدون خارجها باستمرار ، تدفعهم عملية البحث عن المراعي إلى الانتشار في المناطق البعيدة ، حيث تتوسع الرقع الزراعية وتنمو المدن ملقية إياهم أكثر فأكثر في الصحارى الكبرى. ويصبح النمو الطبيعي لهذين الفرعين من الاقتصاد الواحد تضاداً عميقاً ، فالمدينة تقوم بالانتشار وتوسيع رقع سيطرتها ، وهي في بداية تشكلها تجمع بين الزراعة والرعي ، حينما تكون أقرب للقرية ، ولكنها بعد ذلك تغدو متخصصة في إنتاجها ، مما يجعلها بحاجة إلى الإنتاج الرعوي . إن التخصص يؤدي إلى نمو الإنتاج المتنوع ، ولكن الرعاة يصيرون مشكلة عبر مستواهم الاجتماعي والفكري المختلف والمضاد للمدينة. والمدينة باعتبارها مركز التراكم المالي والثقافي ، تغدو في مواجهة للأقسام الريفية والرعوية ، التي تزداد انفصالا عنها.
وإذا كانت المدينة هي قرية في البداية ، ثم تنمو قدراتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية ، نافية الأقسام الرعوية ، فإنها كذلك تعلو على أساسها الريفي ، وبعدئذ تنفصل بشكل كبير عنه ، عبر تكدس الفوائض المالية فيها. لكن القرية تظل في المحيط الحضري المسيطر عليه ، في حين يفلت الرعي من هذه السيطرة ، ويتخذ لنفسه مسارات مختلفة.
وفي البدء نرى في الأساطير السومرية تنافساً غير دموي بين الآلهة الزراعية والآلهة الرعوية ف( الأسطورة السومرية ، تحكي لنا أن الإله إنليلEnlil أراد أن يعمر الأرض ، فخلق لذلك مخلوقين أخوين ، “إيميش ” للعناية بالحيوان ، و” إيتين ” وجعله فلاح الآلهة ) .( 11 ) .
إن المدينة السومرية التي لا تزال لا تعرف التضاد التناحري بين الزراعة والرعي ، تشكل وحدة تناغمية بين الاقتصاديين الوليدين ، ولهذا فإن الإله أنليل ممثل دولة المدينة السومرية ، يجعل للفلاحة إلهاً تابعاً له ، بينما الآخر هو للعناية بالحيوان. ونجد الجانبين الزراعي والرعوي متداخلين بصورة كبيرة : فإينتين ( وجعل سمك البحر يلقي بيضه في المستنقعات والأهوار/ وجعل من نتاج النخيل والأعناب الدبس والخمر / وأكثر من ثمار الأشجار حيثما نبت الكلأ / وجعل الحقول تكثر من غلا لتها) في حين إن إيميش هو الذي ( أوجد الشجر والحقول / وجعل حظائر الماشية والأغنام كثيرة / وأكثر من نتاج المزارع / وجعل الكلأ يغطي الأرض / وملأ البيوت بغلال الحصد/ وجعل الأهراء زاخرة ممتلئة) ، (12).
إن التداخل كبير بين الشخصين الرمزين ، كالتداخل في المستويين الاقتصاديين ، إلا أن الفلاحة هي التي لها الألوهية ، وفيما بعد سينمو التضاد وسيعلو الراعي في الأساطير. فالآلهة أنانا السومرية تعتزم اختيار زوج فيشير لها الإله أوتو إله الشمس باختيار الراعي المكتنز أشياء كثيرة والذي يزخر باللالىء والأحجار الكريمة ، لكنها تفضل الفلاح ” أنكيميدو” ( الذي يكثر من إنتاج الزرع / الفلاح الذي يكثر من إنتاج الحبوب ) ، (13 ).
وفي نهاية القصة تفضل أنانا الراعي.
وتفضل التوراة كذلك الراعي على الفلاح ، ( وكان هابيل راعياً للغنم وكان قايين عاملاً في الأرض . وحدث من بعد أيام أن قايين قدم من ثمار الأرض قرباناً للرب ، وقدم هابيل أيضاً من أبكار غنمه ومن سمانها ، فنظر الرب إلى هابيل وقربانه ، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر) ( تكوين 4 ـ 12 ). ولكن الحدث المساق عبر الرؤية التوارتية الرعوية هنا يحيل الفلاح إلى قاتل.
إن ذلك يعبر عن المسارات التي تشكلت في المشرق (العربي) بتعمق الانقسام بين المزارعين والرعاة.
إن المزارعين المستقرين في بيوتهم وفي مدينتهم المحصنة ، أخذوا يتخوفون من القبائل غير المستقرة التي تعيش في الصحارى ، والتي تواجه مواسم متباينة من نزول المطر أو عدمه ، وتدفعها ظروف الفقر والمجاعات إلى الهجوم على المناطق الزراعية والمدنية. وتشكل المناطق الحضرية الجيوش لملاحقة وإبادة الجماعات ” البربرية ” و” الوحشية ” ، وتتشكل مناطق زراعية ، ومناطق رعوية ، وتنمو القبائل والجماعات و” الأمم ” منقسمة بين التكوينين الكبيرين.
ونجد كيف نظر المصريون القدماء وهم في واديهم الخصب إلى الأمم الرعوية كأجانب ، ووضعوا الإله ( أست) الشيطاني كرمز للرعاة ولعالم ما وراء النهر. ولم يحدث تداخل كبير بين العالم المصري الزراعي والرعاة إلا عبر الهكسوس وشعوب البحر الغازية ، ولهذا لم تتفاقم القوى العسكرية والعنف في المجتمع المصري مثلما حدث في المجتمع العراقي ، حيث التداخل الكبير بين المزارعين والرعاة. ولكنهم بعد طرد الهكسوس خرجوا إلى المشرق وكونوا الإمبراطورية ، ثم اعتمدوا على القوى العسكرية المرتزقة فحدث انهيار عميق في الحضارة المصرية. ولكن لا بد من القول هنا إن الرعاة كانوا دائماً يعيشون على أطراف الوادي وفي سيناء.
وإذا كان الجمهور الفقير أو الغني في دولة المدينة ، أو المملكة ، المحكوم بأجهزة القهر ، أو بفائض المال، لا يستطيع تاريخياً أن يغير النظام الاجتماعي ، حيث إن الدولة هيمنت عليه وقسمته ، فإن الرعاة المنتشرين في الفيافي وهم الأحرار والمسلحون يستطيعون ذلك حين يمتلكون العناصر البشرية والمادية والفكرية التي تجعلهم في مستوى أقوى .
ولهذا نجد إن (الأمم الزراعية) فقدت كثيراً من القدرة على التغيير الثوري الداخلي ، في حين صار الحراك الاجتماعي في أغلبه من (الأمم الرعوية).
إن ذلك يعود إلى أن الطبقة المنتجة الفلاحية ُمفككة في قراها الكثيرة المتباعدة ، وليس لديها قدرات عسكرية كبيرة ، في حين تستطيع الطبقات الحاكمة تخصيص جيش مُجهّز منفصل عن المزارعين ، وهي تجده عادة في القبائل أو الأقسام غير العاملة في الزراعة وفي المرتزقة ، ثم إنها تطبق العيش الإجباري في القرية وتمنع الخروج منها، فتجعل الفلاحين عبيداً في الأرض . وهذا هو النمط المسمى العبودية المُعممة.
وحين تأتي قوى غازية تكون غالباً من هذه القبائل المسلحة الحاكمة أو المنتشرة في الصحارى ، أو أن المدن العبودية المسيطرة تستخدمها أو تستأجرها . لقد كانت الأقوام السامية الأولى كالبابليين والآشوريين والآراميين والعبريين ، أو القوى الإقليمية الغازية فيما بعد كالفرس والمقدونيين والرومان ، أو الأمة السامية الأخيرة وهي العرب ، هم حلقات من الأندياحات الرعوية الكبيرة ، وقد فطن إلى ذلك مؤرخنا أبن خلدون ، ( 14).
إن الفترات والمراحل التاريخية تعطي لكل حملة رعوية طابعها ومداها وآثارها ، وهي إذ ترتبط بمستوى تلاحم القبائل الفكري والعسكري ، عبر المناطق الرعوية التي تكونت فيها ، وبصلاتها وبتحولاتها و بمستوى إنتاجها وثقافتها ، فإن سيطرتها وديمومتها تتحدد بمستوى مقاومة المزارعين كذلك ، الذين لم يكونوا خارج التاريخ ، رغم إن الأمم المسيطرة ستجعل الأمر يبدو كذلك .
5 ــ صراع الرعاة والفلاحين على مستوى إقليمي
إن الأمم الغازية (الرعوية) قد مرت بمراحل وتطورات اجتماعية وفكرية كبيرة ، ولا يمكن دمغها في تكوين مجرد كلي ، ولهذا فإن علينا تتبع الخطوط العريضة لنموها ، والمحصلة الأخيرة لتحولها إلى قوى غازية ، ولماذا تعجز أفكارها الأكثر تطوراً ربما من وعي المشرق(العربي) أن تخترق نواته الصلبة.
فالاخمينيون الإيرانيون ، القبائل الرعوية الفارسية ، والتي سيطرت على المناطق الإيرانية ، وحدث التمايز بين إدارتها الملكية وجمهورها القبلي ، اعتمدت على الفكرة المجوسية في الصراع بين إلهي النور والظلام ، لكنها لم تتدخل في صياغة أديان المنطقة المستعبدة لها ، تاركة الجمهور الشرقي في معتقداته ، ولكنها استمرت في استغلال الشعوب بالطريقة القديمة ، عبر ترك المناطق الزراعية في انفصالها ، وإرسالها للضرائب أو الخراج ، وكأنها عبر حفاظها على هذه الفسيفساء واختلافاتها ، تضمن صراعاتها الجانبية وتبعيتها. وكان هذا بخلاف الأسلوب الآشوري المعتمد على الاستغلال البشع وفرض الإله واعتماد العنف كوسيلة وحيدة للسيطرة.
لاشك إن للفرس الاخمينين دوراً في تطور المنطقة الفكري رغم هذا الاستعباد ، ففكرة النور والظلام ، و مسألة إله الخير والشر ، قامتا باختزال الشبكة المعقدة من آلهة الخير والشر ، وبلورتها في الإله الواحد أو الشيطان ، ولا شك إن هذا مثـل تقدماً روحياً على صعيد الوعي ، مما يعبر عن تقدم المنطقة باتجاه الوحدة السياسية والثقافية. وقد وضع ذلك ( الحدود) الفكرية بين إيران والعالم الخارجي ، المعادي أو التابع ، وجعلها جزءً مهماً من المشرق.
وتتشكل عبر هذا الوعي الصراعي بين النور والظلام اتجاهات الحركة الاجتماعية الإيرانية المختلفة ، فحدود النور ودوره أو اختلاطه بالظلام وغير ذلك من المسائل الغيبية ، تلعب دوراً هاما للوعي ، الذي يحولها إلى فعل اجتماعي ، وتتمكن هذه المسائل المجردة من إقامة التحالفات (النورانية ) ، حين يتسع الأفق الوطني الإيراني لشعوب مؤثرة أخرى.
وعرفت تجربة الشعب الإيراني غنى خاصاً في بلورة سمات المشرق ، فالزرادشتية مثلت المرحلة الأرستقراطية في الهيمنة المنفصلة عن الناس العاملين وتكوين الدولة ” القومية ” ، ثم تشكلت المانوية كاتجاه صوفي غنوصي معبر عن فئات وسطى رافضة لاستبداد الملكية المطلقة وبذخها وحروبها ، وتتوجت العملية الثورية الإيرانية بالمزدكية وهي التي جسدت نضال الفلاحين من أجل الأرض .
لقد عبرت المسيحية عن الآهات العميقة للفلاحين ، ولكنها تراوحت بين الثالوث الإيراني ، أي بين قوى الأشراف والفئات المتوسطة والفلاحين ، فالأب ، مثل آن أو أيل ، الإله المفارق الذي يغدو غير مفارق ، بالتحامه بالابن الذي هو مثل تموز وأدونيس ، يختزل كل ديانات واحتفالات الربيع ، فلا ينفك عن إرثه الأمومي ، لكنه يعبر عن القوى السياسية والثقافية الفاعلة في خلق الصلات بين الأب (السلطة المطلقة المفارقة) والناس ، وهم حينئذٍ الفلاحون الغامضون في المنظومة.
إن حدوث التداخل بين المسيحية والمانوية أمر يشير إلى الطابع المعبر عن الفئات الوسطى حينئذٍ ، وخاصة لأولئك المثـقفين المكافحين بصورة سلمية ، والذين يحاولون تشكيل علاقات مختلفة عن نظام العصر القديم ، أي عن نظام الآلهة ـ الملوك ، إلى نظام الآباء ـ الأبناء ، وهو أمر يشير إلى الأضرار الفادحة ودمار ثروات المنطقة بالبذخ والحروب ، فيغدو نموذج المتقشف والراهب الذي يعمر الصحراء بالزراعة مؤشراً لضرورة تجاوز نظام العبودية المعممة في المشرق .
لكن غزاة آخرين يقدمون من مناطق تداخلت فيها العلاقات الرعوية ـ الزراعية ، فالمقدنيون الذين هيمنوا على الحضارة الإغريقية كانوا نفياً قبلياً أرستقراطياً لحضارة المدن الحرة المتنوعة ، فوضعوا حداً لاضطراب هذه المدن بين طرق مختلفة للتطور ، ولم يعد بالإمكان نمو الطريق الرأسمالي ، وقد كانت الحضارة الإغريقية بتناقضاتها العميقة ، تتوجه إلى انهيار نموذج دولة المدينة الديمقراطية ، وبدء العودة إلى الدولة الاستبدادية المهيمنة على العالم الزراعي ، في حين تتآكل الحرف والصناعات ، فتتدهور الأسس المادية للعلوم ، وتتزايد في الفلسفة الاتجاهات المثالية ، وتتويجها المعروف هو الصوفية .
ولم تنتشر الثقافة الإغريقية في المشرق ، بشكل متساوق لمراحلها، فالمشرق الذي يحضر نفسه للعودة إلى ديانة الخصب بشكل موسع ، والذي رأى رعاة غزاة جدداً ، كان يتوجه لنفي التعددية الوثنية المفتتة لصفوفه ” الوطنية ” ، وكان يبحث ويؤكد العناصر شديدة الغيبية ، المعارضة لثقافة الحضارة اليونانية العقلية المختلفة ، فالعقل اليوناني عنى للسواد الأعظم استغلالا وظلاماً. وحين عكف الرهبان و” الصابئة ” على هذا الإرث اليوناني فإنهم قاموا بوضعه على سرير المشرق الديني ، فقطعوا أطرافه المادية وضخموا في اتجاهاته المثالية والصوفية.
لقد رأوا في اتجاهاتهم حماية لاستقلالهم السياسي وانبعاثا لهم ، وتفكيكاً لدولة الخصم الناهبة المسيطرة ، عبر مستوى موادهم الفكرية ، ومستوى جمهورهم الأمي الزراعي والبسيط.
وكانت الدولة الرومانية شكلاً متطرفاً من سابقتها. وقد أدت أعمالها العنفية والاستغلالية إلى التحضير لصعود القوى الإقليمية ” الوطنية ” ومن الداخل الرعوي هذه المرة.
وقد مثـلت هذه الفقرة قفزة في التحليل ، بسبب التداخل الشديد بين الخارج والداخل في المنطقة ، ولكننا نعود في الفقرة التالية لمتابعة مسار التطور الرعوي الداخلي.
6 ــ بداية حضور الرعاة
في أسطورة الخلق البابلي المسماة ( اينوما ايليش ، أي عندما في الأعالي ) المكتوبة في مطلع الألف الثاني قبل الميلاد ، نجد بعض الثيمات المشابهة للخلق السومري ، فلا تزال الأم هي الخصم ، وهي هنا( تعامة ) لكن يوجد إلى جانبها إله ذكر هو أبسو ، وقد حدث نمو الآلهة الشابة الجديدة في أحشاء الآلهة القديمة مما سبب إزعاجاً لها ، ويحاول أبسو إبادتها ، لكن الإله الشاب (أيا ) ينزع العمامة الملكية عن رأس آبسو، ويضعها على رأسه ثم يذبحه. فخططت تعامة لإبادة الآلهة الشابة التي ذعرت ، ثم أرسلت إليها الإله ( مردوخ ) الذي قتلها ، والذي صنع الأرض والسماء من جسدها ثم خلق الإنسان من دماء إله سجين وقتيل الخ ..
إن بابل وهي تتحول إلى مدينة مهيمنة تستعيد الأسطورة السومرية في مرحلة حضارية مختلفة ، مثلما تعيد تشكيل السيطرة السياسية في وسط وجنوب العراق ، ولكنها أيضاً تبدأ من الأسس العامة السابقة للمجتمع السومري ، حيث القصر والمعبد يتحكمان في الملكية العامة ، والملك يصعد ليتحد بالإله مردوخ ، لقد أعطى البابليون الإله (أيا) مكانة الأب الأول ، إرث الانفصال الاجتماعي والسياسي عن المجتمع الأمومي ، ولكن آبسو يشير إلى صعود الرجل في هذه القبائل الرعوية الأكدية التي استولت على العالم الزراعي بشكل متدرج ، مثلما استولت على ثروته الروحية .
إن هذه العملية التغلغلية الرعوية في عالم الفلاحين ، ستتكرر بشكل مستمر ، وتعيد إنتاج نفسها في طبعات متعددة ، ويتكشف الطابع الرعوي في هذه الدموية التي يتصف بها الإله مردوخ ، التي تبتعد كثيراً عن الروح المسالمة التي اتصفت بها الأساطير السومرية الأولى ، وستقوم الدولة البابلية بتوسيع المدى الجغرافي للحضارة السومرية ، دون تغيير الأسس العامة للنظام الاجتماعي ، ولكن الطابع التوسعي المستمر لسلطة المدينة ـ الدولة ، سيؤدي إلى التهام الجيران ، بحثاً عن الفوائض المالية والثروات ، ويقود هذا إلى الحروب ، وظهور مدينة ـ دولة جديدة ، عبر قبائل أو أمم جديدة ، يغلب عليها الطابع الرعوي ، لتقوم بالتوسع وإعادة إنتاج الإرث الديني السابق ، عبر إلهها الخاص ، أو ملكها الكاهن الخ..
إن الرعويين الساميين وهم يبدأون التحكم التدريجي في منطقة المشرق(العربي) سيكونون متداخلين مع الأقوام الزراعية الأولى، بشكل كبير. ولكن الرعاة فيما بعد سيتسعون ويهيمون . إن الأكاديين ، بفرعيهم البابلي والآشوري سيكونون القوى الأولى من الأقوام الرعوية المهيمنة وسيجعلون السيطرة تعم المشرق ، وهم الذين سيقومون بالتوسعات الحربية والسرقة المسلحة الواسعة والدموية للمناطق الأخرى ، فيتعزز الطابع الإمبراطوري ويتحول الإله ـ الملك إلى الضراوة والوحشية الهائلة.
ولاشك إن العبرانيين هم أيضاً من هؤلاء الرعاة الذين تاهوا بين الأمم القوية ، ثم سيأتي الكنعانيون ، الذين سيندغمون بالزراعة والتجارة ، ثم سيأتي الآراميون ، الموجة قبل الأخيرة للرعاة ، وأخيراً سيكون العرب التتويج النهائي لتطور الرعاة وانتقالهم إلى المناطق الزراعية.
7 ــ مقاومة أولى للاستبداد
في هيمنة الملك ـ الكاهن على المدينة لا تتشكل السلطة الشاملة الدموية إلا بصورة تدريجية تاريخية ، فهذه السيطرة المتشكلة في عالم زراعي ، لم يفقد ترابطه القبلي ، ولا جذوره الأمومية ، تتوقف على النمو المتواصل لرقعة المدينة ـ الدولة ، وقد أعطى السومريون هذا الاتساع البطيء الطويل للانتقال من المدينة ـ الدولة إلى الدول ــ المدن المتعددة. وقد لعبت قوى الإنتاج ووسائل المواصلات النهرية والحيوانية المحدودة دورها في النمو البطيء للتوحيد السياسي.لكن الأكاديين، القبائل الزاحفة على الوسط العراقي قامت بتسريع العملية التوحيدية . ولهذا فان الفئات التجارية المختلفة ، كانت تنمو وتتسع. وكان هذا مجالاً للتطور الفكري والاقتصادي المتنوع.
وكذلك كانت مجالس القبائل والمدن الاستشارية تشارك الحكام في إدارات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
لكن الصعود المستمر لآلة الدولة العسكرية كان يقضي على هذه الأشكال الجنينية من الديمقراطية ، حتى إذا وصلنا للحكام المطلقين فإن هذه المؤسسات تتوارى ، وتصبح البنية الاجتماعية ، بمختلف مستوياتها موظفة لهؤلاء الملوك، الذين يجرون بلدانهم للحروب التوسعية التي تعود على سكان الدولة بالكثير من الموارد والعبيد ، وتوسع المداخيل والتجارة ، والإنتاج الثقافي ، غير إن الشعوب المغلوبة والأقوام الرعاة البعيدة ما يلبثوا أن يشنوا الحروب ويثوروا ، ويؤدي ذلك كله إلى الخراب للمالك الزاهرة ، وإلى سؤ الأحوال والمذابح.
في الصعود المستمر للطغيان السياسي، أو في أزمنة صعود دور الملوك والكهنة الحضاري (التقدمي) في البدء ، تتشكل الأدبيات الدينية، التي لا تضع في اعتبارها دور الناس ، وهو الجمهور المؤسس للمدينة وإنتاجها ، حيث ذوبان جمهور القبيلة في سيطرة زعماء العشائر ، المترافق مع نمو الأجهزة القسرية ، وعبر غلالة الدين التعميمية السحرية، وفي الاحتفالات الطقوسية ، خاصة طقوس الربيع والخصب ، ولكن مع تفاقم الآثار السلبية لهذا التفرد المطلق للطبقة الملكية ـ الكهنوتية ، والاستغلال البشع ، وكوارث الحروب ، فإن كل هذا يؤدي إلى تململ بعض المثقفين والأصوات المتفردة الحساسة ، مثل شكاوى الفلاح المصري الفصيح ، والمثقف البابلي الذي يقول مخاطباً إلهه بلغة شكوى واحتجاج: ( الطعام وفير في كل مكان ، لكن طعامي الجوع/ في اليوم الذي قسمت الأنصبة على الناس / كان نصيبي هو الألم والعناء.) ، (15 ).
إلا أن أفراد المثـقفين هؤلاء يختلفون عن الجمهور العام ، إنهم قادرون على إنتاج وعي غير ديني ، ولكن الجمهور العادي الأمي المنخرط في آلة الدولة العسكرية والاقتصادية والفكرية، لا يستطيع إلا أن يتقبل الوعي الديني المكرس عبر آلاف السنين ، ويتحسس مظاهره وأدواته عله يجد منفذاً ُيسّرب من خلاله معاناته. وهكذا وجد في طقوس الخصب ، التي فيها الموت والميلاد ، وعذاب إله ما ، صلة روحية واجتماعية غامضة ، بهذا الإله على مستوى ملموس ، يلغي به الاستقطابية الشديدة بين السماء والأرض ، بين الفوق والتحت ، بين الحاكمين والمحكومين ، حيث يتحمل الإله جزءً من عذاب الجمهور ، ويكون معه في احتفالاته الطقوسية ، ولا يشكل ذلك خطورة لدى الطبقة الحاكمة من أتساع ونمو مكانة هذه الإله ، الذي سيكون مسؤولا عن العالم السفلي ، أو يعطى أية وظيفة غيبية أخرى تبعده عن المسألة الأرضية للحكم وموارد الخصب.
إن المجمع الإلهي قادر بعد زمن من الصراع على إعادة تشكيل الإله ، وتوظيفه بما يخدم سيرورة النظام الاجتماعي والديني ، ولكن هذا لا يمنع من احتواء النظام الغيبي على تمردات من قبل بعض الإلهة الذين يسرقون أشياء مقدسة ومن خيانة بعض الآلهة للأوامر المركزية من قبل الإله المهيمن ، الذي أراد فناء البشر لأنهم أزعجوه بكثرة شغبهم ، مما دفع الإله لأن يخبر بموعد الطوفان القادم ، فقام هذا ببناء سفينة استطاعت أن تنقذ الجنس البشري من الغضب الإلهي.إن هذه الثغرات التي تتشكل للفعل البشري داخل المنظومة الإلهية المهيمنة في عليائها ، ليست من فعل البشر ، بل من فعل الآلهة ، حسب بناء الأسطورة ، ولكن بعض البشر يحصلون على مكانة خاصة لدى هذه الآلهة ، تجعل آلهة ما يساعدونهم أو ينقلون لهم أخباراً أو أدوات وقوى مهمة.
هكذا نجد البشر وهم يخلقون المجمع الإلهي المسيطر عليهم ، حسب مراحل سابقة طويلة ، يخلقون كذلك أشكال التأثير على هذا المجمع ، حسب فعل بشري جديد ، ولحاجات جديدة ، وفي داخل المنظومة الغيبية المسيطرة خلال هذه المرحلة. ومن هنا فإن الاستغلال الطويل للطبقة المسيطرة ومغامراتها العسكرية وتفردها بالحكم و(الخراج) ، يقود الجمهور الفقير إلى تصعيد آلهة المعاناة والتحول كتموز ، الذي يتجاوز آلهة الانفصال والانعزال ، خاصة آن أو أيل ، ذلك الإله الذكر ممثـل السلطة المفارقة ، ولكن هل يستطيع تموز أن يتغلب على الهوة بين الحكام والمحكومين ، وهل تستطيع الاحتفالات الطقوسية الربيعية ، بما فيها من أفراح واندماج بين الملوك والفلاحين ، أن تشكل تحولاً في حياة الجمهور المستغل ؟
إنها بكل تأكيد تضع أسساً ثقافية جديدة لعالم المشرق (العربي) ، عبر صعود دور الفلاحين ، المُسيّطر عليهم كذلك من قبل القوى المهيمنة ، التي تدخل الإله المعذب المتضافر مع الدورة الزراعية ، والذي يكون جزءً حميمياً من عالم هؤلاء ، فتخلق أدوات جديدة للسيطرة عليهم ، وكذلك مخارج ومتنفسات للحلم ، بحيث يصير الغيب القادم ، جزءً من الحلم الشعبي بديمومة جديدة ، ويبدأ العالم الآخر في الصعود بحيث يغدو ملكية عامة مشاعة ، وبديلاً عن الملكية العامة المسروقة . ويظهر توحد المشرق (العربي) هنا في تشكل نموذج شبه موحّد للإله المعّذب ، فتموز نجد إلى جنبه أدونيس في فينقيا أو بلاد كنعان ، أو أوزوريس في مصر . إن وحدة الآلام والأحلام هذه تشكل خلفية هامة لوحدة السكان في المنطقة ، ولما هو مشترك بين المنتجين. كما تعبر كذلك عن الاغتراب وهيمنة الدول والمستغلين.(16).
إن الغيب القادم المأمول ، وبطبيعة الحال لم يأت بلا نضال ، إذا كان مشاعاً بشكل كلي فلن يفيد النظام الاجتماعي وسيطرة الحكام الذين قبلوا به ، بعد مسيرة طويلة من الرفض واحتكار اليوم الآخر ، ولهذا فإن تعديلات وتحويرات هامة تشكلت على هذا القبول ، بحيث يكون المنتقل إلى العالم الخالد ، مواطناً صالحاً في حياته ، لم يهن الآلهة ووصاياها ، أي لم يتمرد على نظام السيطرة الذي وضعه الملوك ــ الكهنة. ولا شك إن ثمة قيماً إنسانية هامة في هذه الوصايا ، فليس الأمر مخططاً شريراً ، بل هو عملية صراع معقدة ، متداخلة ، بين ما هو استغلالي أناني وما هو شعبي باحث عن الخير ، وعلى العموم فإن حصول منفذ من نظام القهر(الدنيوي) ، الذي سدت الآفاق في تبديله والقضاء عليه ، سيكون كذلك عملية معقدة تنمو عبر التفاعلات ، بين جنة ديلمون التي صنعها الخيال والحلم السومري ، في مياه الينابيع والنهر وعلى جزيرة البحرين ، وبين المحرقة ـ المزبلة التي ظهرت شرق القدس ، والتي أسمها (جهنم) ، (17 ).
إن تصعيد عناصر المقاومة في الدين تم على نحو بطيء وطويل ، فاليوم الآخر لم يكن إلا من نصيب الطبقة العليا في مصر ، ومع صعود عبادة أوزوريس تمت ” دمقرطة ” البعث ليكون من نصيب الجميع ، وأخذت الأعمال الحسنة تغدو هي المعيار ، وبطبيعة الحال فإنها لم تكن تفلت من ميزان المسيطرين ، لكن عبرها تشكلت عجينة مشتركة للمؤمنين.
وفي هذه المادة الثقافية المشتركة تتم عمليات التعبير عن الآلام والصبر والانتظار والغضب والحلم.
July 3, 2022
عبÙÙÙÙÙÙÙداÙÙÙ Ø®ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙØ©: اÙÙظر ب٠ÙضÙعÙØ© Ù٠تارÙØ Ø§ÙØ¥ÙساÙ
 عبÙÙÙÙÙÙÙداÙÙÙ Ø®ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙØ©: اÙÙظر بÙ
ÙضÙعÙØ© Ù٠تارÙØ Ø§ÙØ¥ÙساÙ
عبÙÙÙÙÙÙÙداÙÙÙ Ø®ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙØ©: اÙÙظر بÙ
ÙضÙعÙØ© Ù٠تارÙØ Ø§ÙØ¥ÙساÙÙا ÙÙ
ث٠تارÙØ® اÙأدÙا٠سÙÙ ÙاØد باÙÙ
ائة Ù
٠تارÙØ® اÙØ¨Ø´Ø±Ø ÙÙ ØÙ٠تØت٠اÙأسطÙرة ا٠99 % Ù
ÙÙ.
Ø£Ù
ا تارÙØ® اÙعÙÙ
ÙØت٠اÙØ¢Ù ÙÙ
Ùص٠ÙØ´ÙØ¡Ù Ù
Ù Ø°ÙÙ.
ÙÙÙذا ØÙ٠ظÙرت٠اÙأدÙاÙÙ ØاÙÙت٠أ٠تخÙÙ Ù
٠اÙأسطÙرة باÙاعتÙ
اد عÙ٠بعض٠رÙائزÙا.
تارÙخ٠اÙعÙÙÙ
اÙضئÙÙ Ùا ÙعÙ٠عدÙ
Ø£ÙÙ
Ùت٠اÙجبارة ÙÙÙÙ Ùسبة ÙجÙد٠ÙÙ ØÙاة اÙبشر Ù
ØدÙØ¯Ø©Ø ÙØت٠Ù٠اÙعصر اÙØدÙØ« Ùإ٠اÙاختراعات ÙاÙصÙاعات ÙائÙØ© ÙÙ٠أ٠تتجسد ÙتارÙØ® ÙÙر٠عÙÙ
Ù ÙÙ ØÙاة اÙÙاس ÙÙذا Ø£Ù
ر آخر.
ÙÙ
Ù ÙÙا Ùجد أ٠تارÙØ® اÙÙ
جاÙÙÙ ÙاÙطغاة ÙاÙÙ
رض٠اÙÙÙسÙÙÙ ÙأصØاب اÙÙÙÙسة اÙØ°Ù٠صارÙا زعÙ
اء ÙÙادة Ø£Ù
براطÙرÙات ÙØ£Øزابا٠ÙأشعÙÙا اÙØرÙب اÙØªÙ Ø±Ø§Ø Ø¶ØÙتÙا اÙÙ
ÙاÙÙÙ Ù
٠اÙبشر ÙÙØ°Ù٠اÙغابات ÙاÙÙ
د٠ÙاÙأشÙاء Ù
٠اÙجÙ
اد ÙاÙÙØ¨Ø§ØªØ ÙÙÙ
Ø£Ùثر بÙØ«Ùر Ù
٠اÙÙÙاسÙØ© اÙعÙÙاÙÙÙÙ.
ÙÙØ°ÙÙ ÙاÙت اÙجÙ
اعات اÙدÙÙÙØ© اÙÙ
ÙÙÙسة ÙاÙعصابÙØ© ÙاÙÙ
جÙÙÙØ© بÙÙرÙا ÙسÙطاتÙا ÙØ£ØÙاÙ
Ùا اÙباترة بÙت٠اÙبشر ÙاÙتضØÙØ© بÙÙ
ÙإستغÙاÙÙÙ
Ø£Ùثر Ù
Ù Ùطرات اÙÙ
ØÙطات ÙشعÙر اÙرؤÙس Ù٠شت٠اÙأزÙ
ÙØ©!
ÙÙÙ
ا أ٠اÙعÙÙÙ
Ù
Ø«Ù Ùطرة Ù٠اÙÙ
ØÙØ·Ø§ØªØ ÙÙØ°Ù٠اÙعÙ٠اÙØ¥ÙساÙÙ ÙØظة ÙاÙ
ضة Ùادرة Ù٠اÙÙجÙد.
اÙØ¥Ùسا٠ÙائÙ٠خراÙÙØ Ùا Ùعتر٠بأÙ٠جزء٠ضئÙÙ Ù
٠اÙطبÙØ¹Ø©Ø Ø£Ù
٠اÙت٠اÙÙطع ع٠ثدÙÙا بأÙÙاÙ
٠اÙØ®ÙاÙÙØ©Ø ÙÙ
ع Ø°ÙÙ ÙÙا Ùزا٠Ùعتبر٠اÙأسد٠Ù
ÙÙÙÙ Ù٠اÙØºØ§Ø¨Ø©Ø ÙاÙذئب٠رÙÙÙÙ ÙÙ ØÙ
Ùات٠ÙتصÙÙØ© اÙÙ
عارضÙÙØ ÙاÙØÙØ© سÙدت٠اÙت٠تÙدÙ
Ù٠اÙسÙ
ÙÙ
Ø(ÙÙا٠اÙعسÙ٠اÙÙ
سÙ
ÙÙ
Ù
ادة ÙتغÙÙر اÙتارÙØ® ÙاÙØÙاÙ
).
اÙØ¥Ùسا٠اÙخراÙÙ ÙستخدÙ
شت٠اÙØ£ÙÙار ÙÙجع٠Ù
Ù ÙÙس٠اÙÙائ٠اÙÙ
ختÙ٠ع٠اÙطبÙØ¹Ø©Ø ÙÙÙÙ ÙÙاÙÙÙÙا سارÙØ© Ù٠جسÙ
ÙØ ÙØ£Ù٠خطأ بÙÙÙÙج٠Ù٠ترÙÙب٠ÙØÙÙ٠إÙ٠عدÙ
.
عاش اÙØ¥Ùسا٠بأغÙبÙØ© تارÙخ٠عÙ٠اÙØ£ÙÙاÙ
Ø ÙØ°ÙÙ Ùأسباب Ù
ÙضÙعÙØ© خارجة٠ع٠إرادت٠ÙÙائÙØ ÙاÙطبÙعة Ù
سÙطرة عÙÙ٠بÙ
ÙÙاد٠ÙÙ
ÙتÙØ ÙÙ٠طبÙعة ÙÙست Ù٠خدÙ
تÙØ Ø¨Ù Ù
عادÙØ© ÙÙØ ÙØ£ÙÙ Ùشأ داخ٠تطÙراتÙا اÙت٠ÙÙ
ÙتØÙÙ
ÙÙÙØ§Ø ÙÙجد ÙÙس٠داخÙÙØ§Ø ÙØ±Ø§Ø ÙسÙطر عÙÙÙا بصعÙبات جÙ
Ø© ÙØ«Ùرة خارÙØ©Ø ÙتارÙخ٠اÙØÙÙÙÙ Ù
بÙ٠عÙÙ Ùذ٠اÙسÙطرة اÙÙ
ØدÙدة.
ÙÙ
ا Ùاج٠Ù
٠داخ٠تارÙخ٠اÙØ¥ÙساÙ٠عÙبات Ùا تÙ٠خطÙرة ÙÙ
أساÙÙØ© ع٠عÙبات اÙطبÙعة اÙضارÙØ© اÙعائشة عÙÙ ÙØÙ
Ù ÙعÙÙÙØ ÙظÙرت Ø£ÙظÙ
Ø© ØÙÙاÙÙØ© طبÙعÙØ©Ø ÙÙ٠تارÙØ®ÙØ© Ù
ع Ø°ÙÙØ ØªÙÙØ´ Ø£ÙاÙ
٠اÙÙÙÙÙØ© Ù٠اÙÙجÙØ¯Ø Ù٠اÙ
تداد ÙØÙÙاÙÙØ© اÙأسد ÙاÙذئب ÙاÙØÙØ©Ø Ùغدا Ù
Ø«Ù ÙÙطة اÙزÙت عÙ٠اÙصÙÙØØ© اÙÙ
ÙتÙØ¨Ø©Ø ÙÙÙÙ ÙÙتج Ù
ÙÙ ÙÙر عÙÙاÙÙØ
Ùغد٠دÙاع اÙØ¥Ùسا٠اÙØ£ÙÙ Ù٠اÙتÙ
س٠باÙÙ
عÙشة اÙبسÙØ·Ø©Ø Ø£Ù ÙÙÙÙ ÙÙ Ù
Ùز٠ÙعائÙØ© ÙاÙ
ØªØ¯Ø§Ø¯Ø Ø£Ù ÙÙÙ٠أعÙ٠درجة Ù
٠اÙجÙ
Ù ÙاÙضÙØ¯Ø¹Ø ÙØت٠ÙÙ Ùذ٠اÙÙ
ÙاÙØ© اÙØÙÙاÙÙØ© اÙÙ
تدÙÙØ© ÙÙا اÙطبÙعة اÙÙاسÙØ© تترÙÙ ÙÙا اÙطبÙعة اÙØÙÙاÙÙØ© اÙسÙاسÙØ© تدع٠ÙعÙØ´ بÙراÙ
Ø©.
ÙÙÙتا اÙطبÙعÙت٠ÙÙا اÙبراÙÙÙ ÙاÙزÙاز٠ÙاÙÙÙض اÙبØر٠ÙاÙØ£Ù
Ø±Ø§Ø¶Ø ÙÙÙطبÙعة اÙثاÙÙØ© اÙسجÙÙ ÙاÙدÙتاتÙرÙات ÙاÙØرÙب ÙاÙتجارب اÙÙÙÙÙØ© ÙاÙØ£ÙظÙ
Ø© اÙباطشة اÙÙاÙ
سئÙÙØ© اÙعداÙÙÙØ©.
ÙÙظ٠Ù
Ùجئ٠اÙØ£Ù
Ù ÙاÙØÙÙ
اÙأسطÙرة ÙاÙدÙÙØ ÙÙ
ا ÙØ®ÙÙا٠Ù٠عاÙÙ
ا٠سعÙدا٠Ù٠أÙÙÙ ÙÙÙاÙتÙØ ÙÙد ÙتØÙÙا٠ÙÙ
ا Ø£Ùضا٠إÙ٠جزء Ù
٠اÙطبÙعة اÙØÙÙاÙÙØ© اÙØ¨Ø§Ø·Ø´Ø©Ø ÙØ£ÙÙÙ
ا جزء Ù
٠تÙÙÙر اÙØ¥Ùسا٠اÙتارÙØ®ÙØ ÙÙÙ
ا دÙر ÙÙضÙÙ ÙØ¥Øداث تÙدÙ
ÙÙ ØÙاتÙØ ÙÙÙÙ
ا دÙر اÙزÙزاÙØ© اÙت٠تعتÙÙ Ùدرات٠ÙتØجÙ
عÙÙÙØ Ù
٠أج٠Ù
صÙØØ© اÙÙÙ٠اÙØÙÙاÙÙØ© اÙاستغÙاÙÙØ© اÙت٠ØÙÙتÙÙ
ا Ø¥Ù٠دÙر تعطÙÙ٠بدÙا٠Ù
٠اÙدÙر اÙÙÙضÙÙ.
ÙÙÙذا Ùإ٠تارÙØ® اÙØ¥Ùسا٠بÙ
عظÙ
Ù Ù٠تارÙØ® اÙØÙÙا٠اÙضارÙØ ÙØ£Ùظر Ø¥Ù٠جÙÙØ´Ù ÙاسÙ
ائÙØ§Ø ÙÙ٠أخذت Ù
٠اÙØÙÙا٠رÙ
ÙزÙØ§Ø ÙÙ
٠اÙطبÙعة اÙجائرة عÙاÙÙÙÙØ§Ø Ø¬Ù
اعة اÙÙÙÙد اÙسÙØ¯Ø ÙاÙصاعÙØ©Ø ÙاÙØ±Ø¹Ø¯Ø ÙاÙØ´Ùاب اÙÙاÙ
Ø¹Ø ÙاÙØ£Ø³Ø¯Ø ÙاÙØ¶Ø¨Ø¹Ø ÙاÙÙÙد اÙØ®..
Ùأخذت Ù
٠اÙطبÙعة اÙبعÙدة اÙÙاÙ
باÙÙØ© باÙÙ
شاعر ÙاÙÙÙÙب ÙاÙعÙÙ٠رÙ
ÙزÙØ§Ø ÙÙاÙÙا دÙÙØ© اÙØ´Ù
س ÙØددÙا اÙضباط بأÙÙÙ
Ø°Ù٠رتب Ù
٠اÙÙجÙÙ
ÙÙÙرسÙا ÙÙÙÙ
اÙابتعاد ع٠اÙØ¥ÙساÙØ ÙÙاÙÙا Ø¢ÙÙØ© اÙÙÙ
ر ÙدÙÙØ© اÙÙÙ
ر ÙاÙتÙجا٠ÙÙضعÙا اÙÙسÙر ÙاÙÙ
ÙاشÙر ÙاÙسÙÙ٠رÙ
Ùزا٠Ù٠أعÙاÙ
ÙÙ
Ùتد٠عÙ٠اÙأسÙا٠ÙاÙÙ
خاÙب اÙضارÙØ©!
ÙÙ٠تعتر٠صراØØ© بأÙÙا جزء Ù
٠اÙطبÙعة اÙÙاسÙØ© ÙÙ
٠اÙجÙ
اعة اÙØÙÙاÙÙØ© اÙØ¢ÙÙØ© ÙÙØÙ
اÙبشر!
ÙÙ٠اÙØ®Ùا٠تÙÙ٠أÙÙا غÙر Ø°ÙÙØ ÙÙ٠اÙاÙتÙ
ا٠ÙاÙØ·Ùارة ÙاÙÙØ¯Ø§Ø³Ø©Ø ÙÙ٠دÙÙØ© اÙÙط٠اÙÙاØد ÙاÙÙاÙÙÙ ÙاÙدستÙر ÙاÙدÙÙ
ÙراطÙØ©!
Ùا ترÙد اÙدÙ٠أ٠تÙÙ٠بأÙÙا جعÙت اÙأسÙد تØÙÙ
ÙتÙÙØ´ Ù
٠اÙÙØÙÙ
Ùتستأثر باÙØ£Ù
Ùا٠ÙتتÙاعب بأÙ
Ùا٠اÙÙÙراء اÙÙزÙÙØ©Ø Ø¨Ù Ø£ÙÙا تضع Ø£ÙÙعة (Ø¥ÙساÙÙØ©) ÙÙÙ ÙجÙÙÙا ÙÙد Ùا٠اÙشاعر (إذا رأÙت٠ÙÙÙب٠اÙÙÙØ« بارزة ..)Ø ÙÙ٠تعبÙر ÙÙس ع٠Ù
شابÙØ© Ø´ÙÙÙØ© بÙاÙÙØ© ب٠إدرا٠ÙطبÙعة اÙسÙطات.
ÙÙا٠اÙعاÙ
٠اÙÙصÙØ (اÙØ°Ùب Ù
ا ÙÙرÙ٠عبثاÙ)Ø ÙØت٠ÙرÙÙØ© Ùذا اÙÙØØ´ اÙت٠تبد٠صÙÙعا٠إÙساÙÙا٠تستÙد٠اÙÙØÙ
اÙاÙتصاد٠أ٠اÙبرÙتÙÙÙØ ÙÙد تداخÙت اÙÙØÙÙ
.
ÙÙÙ
ا أ٠اÙعÙÙÙ
تÙ
Ø«Ù Ø´Ùئا٠رÙ
زÙا٠Ù٠اÙØ£Øصاء اÙعÙÙاÙÙ ÙتارÙØ® اÙبشر اÙÙاعÙÙاÙÙ ÙاÙخراÙÙ Ùإ٠اÙجÙÙد اÙÙ
ÙاضÙØ© ÙØ£ÙسÙØ© تارÙØ® اÙØ¥Ùسا٠ÙÙ Ù
Ø«Ù Ø°ÙÙØ ÙربÙ
ا Ø£ÙÙØ Ùأ٠اÙجÙÙد Ù٠تشÙÙÙ Ù
جتÙ
عات Ø¥ÙساÙÙØ© خاÙÙØ© Ù
٠اÙأسÙد ÙاÙÙÙÙد ÙØ´Ù
Ùس اÙÙ
Ùاج٠ÙاÙÙ
طار٠اÙÙازÙØ© عÙ٠جÙ
اجÙ
اÙØ¨Ø´Ø±Ø ÙÙ Ùادرة ÙÙÙÙ
ا تÙÙØ ÙتصÙ
د Ùأ٠اÙØÙÙاÙات اÙبشرÙØ© تظÙر٠بشÙÙÙ Ù
ستÙ
ر Ù
٠داخ٠Ùذ٠اÙجÙ
اعات ÙاÙÙ
جتÙ
عات بسبب ÙصÙر اÙتÙظÙÙ
ات ÙاÙÙع٠ÙاÙÙ
راÙبة ÙتخÙ٠أساÙÙب اÙØ¥Ùتاج Ùد٠اÙبشر عÙ
ÙÙ
اÙ.
ÙÙذ٠اÙØÙÙاÙات اÙبشرÙØ© ترÙد أ٠تستØÙØ° عÙ٠اÙغÙÙÙ
Ø© اÙاÙتصادÙØ© ÙتÙÙØ´Ùا بسرعة ÙتØتÙظ بÙØ§Ø Ùتجع٠ذÙ٠أسÙÙب عÙØ´Ùا ÙسÙطرتÙا.
ÙÙذا ÙعتÙ
د عÙÙ Ù
د٠ÙÙظة اÙÙ
ذبÙØÙÙ ÙاÙÙ
سÙÙØ®ÙÙ ÙاÙعÙ
اÙØ Ø¯Ø¬Ø§Ø¬ اÙتارÙØ® اÙØ·Ø§Ø²Ø¬Ø ÙÙ ÙÙتبÙÙÙ ÙÙÙاÙÙ
Ù٠أÙ
ÙترÙÙ٠اÙذئاب ترع٠ÙÙ Ù
رع٠اÙغÙÙ
Ø
July 2, 2022
عبÙÙÙÙÙÙÙداÙÙÙ Ø®ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙØ©: اÙباØØ« ع٠أÙ٠تÙÙÙر٠عربÙ
اÙشارÙØ© – عثÙ
ا٠ØسÙ:
Ù
ا اÙذ٠جع٠اÙÙ
بدع اÙØ®ÙÙج٠عبداÙÙÙ Ø®ÙÙÙØ© Ùشغ٠ÙÙس٠دÙعة ÙاØدة بÙÙ Ùذ٠اÙأشÙاء اÙÙ
غاÙ
رة Ù٠اÙØ«ÙاÙØ© ÙاÙرÙاÙØ© ÙاÙÙصة ÙاÙشعر ÙاÙرسÙ
ÙاÙÙ
Ø³Ø±Ø ÙاÙسÙÙÙ
Ø§Ø ÙÙ ÙØ£Ù ÙÙ ÙاØد Ù
Ù Ùذ٠اÙÙ
جاÙØ§ØªØ Ùا بد Ø£Ù ÙÙÙ٠إÙساÙÙا٠ÙÙاعÙا Ù٠اÙØÙاة اÙاجتÙ
اعÙØ© ÙاÙØ«ÙاÙÙØ© ÙاÙÙÙرÙØ© Ù
٠دÙÙ ÙÙد Ø£Ù Ø´Ø±Ø·Ø Ø±Ø¨Ù
ا ÙØµØ Ùذا Ù٠سÙرة ÙØÙاة اÙراØ٠اÙبØرÙÙÙØ Ø§Ùذ٠آثر Ø£Ù ÙÙÙ٠خاÙÙا٠تÙ
اÙ
ا٠Ù
٠اÙØ£ÙاÙÙØ©Ø Ø§Ùت٠ÙÙ Ù
شرÙع Ù
ستÙ
ر ضد ÙÙ Ù
ا ÙÙ ÙÙس Ø«ÙاÙÙØ§Ø ÙØ£Ùا ÙÙÙÙ Ù
ÙØازا ÙجÙØ© Ø£Ù ÙتÙار Ø£Ù ØØ²Ø¨Ø ÙØ£Ù ÙÙاج٠ÙÙ Ùذ٠اÙÙتÙءات اÙت٠تبشر بعدÙ
ÙØ© اÙØ¥ÙساÙØ ØÙØ« تتÙاذÙ٠اÙÙ
صÙØØ© ÙاÙØ£ÙدÙÙÙÙجÙا ÙاÙÙزاعات Ù
٠شت٠بÙاع اÙأرض .
Ùا٠عبداÙÙÙ Ø®ÙÙÙØ© اب٠بÙئت٠اÙØ®ÙÙجÙØ© ÙاÙعربÙØ© ÙÙجس بÙÙاجسÙا ÙÙشعر بÙبضÙØ§Ø ÙÙتب Ù
ÙاÙات Ùدراسات سÙاسÙØ© ÙاجتÙ
اعÙØ© ترصد تطÙرÙØ§Ø ÙÙÙ٠بدأ بÙÙ٠اÙÙصة ÙاÙرÙاÙØ© Ù
ÙØ° Ø£Ùاخر ستÙÙات اÙÙر٠اÙÙ
اضÙØ ÙÙ
ا Ùتب Ù٠اÙÙÙد Ù
عبرا٠ع٠أسÙÙب٠ÙÙ
ÙاÙÙÙ ÙتبÙÙ Ø®Ùار اÙاÙØÙاز ÙÙجÙ
ا٠ÙاÙÙÙØ© ÙاÙÙظاÙØ© Ù
Ù Ø®Ùا٠رÙاÙات: “ÙØ٠اÙشتاء”Ø “اÙرÙ
Ù ÙاÙÙاسÙ
ÙÙ”Ø “ÙÙÙ
Ùائظ”Ø “دÙشة اÙساØر”Ø “جÙÙ٠اÙÙØ®ÙÙ”Ø “سÙد اÙضرÙØ”Ø “اÙÙØ¢Ùئ”Ø “اÙÙرصا٠ÙاÙÙ
دÙÙØ©”Ø “اÙÙÙرات”Ø “أغÙÙØ© اÙÙ
اء ÙاÙÙار”Ø “اÙضباب”Ø “ÙØ´Ùد اÙبØر”Ø “اÙÙÙابÙع”Ø “اÙØ£ÙÙÙ”Ø Ù”Ø§ØºØªØµØ§Ø¨ ÙÙÙب” ÙغÙرÙا .
Ùا٠اÙراØÙ Ù
عÙÙا٠بترجÙ
Ø© Ù
ا ÙÙتب Ù٠ضÙØ¡ بعد٠اÙØ¥ÙساÙÙØ ÙÙ٠اÙØ°Ù ÙÙ
Ù٠تÙÙ
س٠ÙÙ ÙÙ Ù
ا Ø£Ùجز سÙاء Ù٠اÙرÙاÙØ©Ø ÙÙ
Ù ÙبÙÙا اÙÙØµØ©Ø ÙÙ٠تÙجÙ٠اÙÙÙر٠Ùدراسات٠اÙÙÙدÙØ© ÙاÙاجتÙ
اعÙØ©Ø ÙÙ٠اÙØ°Ù ÙØ´Ùر Ø¥ÙÙ٠اÙشاعر ÙاÙÙاÙد اÙبØرÙÙ٠جعÙر اÙجÙ
ر٠اÙØ°Ù Ùر٠أ٠Ù
شرÙع عبداÙÙÙ Ø®ÙÙÙØ© اÙرÙائ٠Ùا٠ÙرتÙز عÙ٠اÙتارÙØ®Ø ÙÙ٠اÙتارÙØ® اÙØ°Ù Ùا٠ÙÙرب٠Ù
Ù ÙÙÙ
اÙØØ§Ø¶Ø±Ø ÙرÙاÙØ© “اÙÙÙابÙع” بأجزائÙا اÙØ«Ùاثة ÙاÙت رÙاÙØ© تارÙØ®ÙØ©Ø ÙÙ٠أÙضا تÙربÙا Ø¥ÙÙ Ù
ØاÙÙات٠ÙÙÙÙ
اÙØاضر اÙÙ
تØÙÙ ÙاÙÙ
تÙØªØ±Ø ÙÙ٠إذ٠تتتبع ÙرÙا٠Ù
٠اÙتØÙÙات ÙÙد سÙطرت ÙÙÙا Ùغة اÙشعر عÙ٠اÙÙØ«Ùر Ù
Ù Ù
ساØات اÙØ³Ø±Ø¯Ø ÙاÙ
تازت Ù
Ù ØÙØ« اÙتÙÙÙ٠اÙÙÙ٠باÙÙÙعÙØ© Ù٠اÙÙ
عاÙØ¬Ø§ØªØ ÙاÙأساÙÙØ¨Ø ÙÙÙ٠اÙجÙ
رÙ: “اÙتارÙØ® بدأ Ù
Ù Ù
عاÙجات٠اÙÙصصÙØ© اÙÙØ«Ùرة Ù
Ø«Ù “ÙØ٠اÙشتاء”Ø ÙصÙÙا٠إÙÙ “ÙÙÙ
Ùائظ”Ø “سÙرة”Ø “سÙد اÙضرÙØ”Ø “جÙÙ٠اÙÙØ®ÙÙ”Ø “اÙرÙ
Ù ÙاÙÙاسÙ
ÙÙ”Ø “دÙشة اÙساØر”Ø ÙغÙرÙØ§Ø Ù
٠دÙ٠أ٠ÙÙأ٠ع٠اÙÙØظة اÙراÙÙØ© ÙاÙتÙج٠إÙ٠اÙÙ
ستÙب٠.
اشتغ٠اÙراØ٠عÙ٠اÙبØØ±Ø ÙÙس باعتبار٠ØÙÙزا٠ÙÙ
ÙاÙاÙØ Ø¨Ù Ø¨Ø§Ø¹ØªØ¨Ø§Ø±Ù Ùعاء اÙعذاب ÙاÙÙ
Ùابدات ÙاÙصراع اÙذ٠عاش٠إÙسا٠Ùذا اÙجزء Ù
٠اÙعاÙÙ
Ø ÙÙÙ
Ù٠اÙÙÙÙ٠عÙ٠أÙثر Ù
٠شاÙد ÙÙØ§Ø Ø¹Ø¨Ø± ÙائÙ
Ø© Ù
٠اÙÙصص اÙÙصÙرة ÙاÙرÙاÙات اÙت٠تÙاÙÙت تÙ٠اÙØ«ÙÙ
Ø© .
Ùأثارت اÙرÙاÙØ© عÙد اÙراØ٠اÙتÙ
اÙ
عدد Ù
٠اÙÙÙØ§Ø¯Ø Ù
ÙÙÙ
ÙÙد ØسÙ٠اÙذ٠رأ٠أ٠اÙرÙاÙØ© اÙبØرÙÙÙØ© ØاÙÙت أ٠تجد ÙÙا Ù
ÙاÙا٠Ù٠اÙÙ
Ø´Ùد اÙسرد٠اÙØ®ÙÙجÙØ ÙÙ
ا ÙÙجت بعÙ٠اÙراصد ÙاÙÙ
تأÙ
Ù ÙاÙÙ
تÙØص ÙÙتراث ÙاÙتارÙØ® اÙعرب٠ÙاÙإسÙاÙ
ÙØ ÙÙÙÙ: “ÙÙد اÙÙب اÙرÙائ٠عبداÙÙÙ Ø®ÙÙÙØ© عÙ٠إصدار أعÙ
ا٠رÙائÙØ© ذات بعد تارÙØ®ÙØ Ùأصدر Ù
٠اÙرÙاÙات: “عÙ
ر ب٠اÙخطاب Ø´ÙÙØ¯Ø§Ù”Ø “عثÙ
ا٠ب٠عÙا٠شÙÙØ¯Ø§Ù”Ø “عÙ٠ب٠أب٠طاÙب Ø´ÙÙØ¯Ø§Ù”Ø “Ù
ØÙ
د صÙ٠اÙÙ٠عÙÙÙ ÙسÙÙ
Ø«Ø§Ø¦Ø±Ø§Ù”Ø Ø¥Ø¶Ø§ÙØ© Ø¥Ù٠اÙÙاÙع اÙØ°Ù ÙعطÙÙ Ù
ÙاÙ
Ø Ø§ÙØÙاة اÙÙ
ستÙبÙÙØ©Ø ÙأعتÙد Ù
ا Ùتب٠اÙرÙائ٠عبداÙÙÙ Ø®ÙÙÙØ© ع٠تارÙØ® اÙبØر ÙاÙغÙØµØ ÙاÙØاÙØ© اÙاجتÙ
اعÙØ© ÙاÙÙ
عÙØ´ÙØ© Ù٠اÙÙ
جتÙ
ع اÙبØرÙÙÙ ÙØ´Ùر Ø¥ÙÙ Ø°Ù٠اÙصراع اÙطبÙÙ Ù٠اÙÙ
جتÙ
ع” .
ÙÙ٠اÙÙ
Ùدا٠اÙÙÙر٠ÙاÙاجتÙ
اع٠أصدر Ùتاب “اÙاتجاÙات اÙÙ
ثاÙÙØ© Ù٠اÙÙÙسÙØ© اÙعربÙØ© اÙإسÙاÙ
ÙØ©”Ø Ø¥Ø° صدر اÙجزءا٠اÙØ£ÙÙ ÙاÙثاÙÙ ÙÙ 600 صÙØØ©Ø ÙÙÙÙÙ
ا ÙتÙاÙ٠اÙÙ
ÙدÙ
ات اÙÙÙرÙØ© ÙاÙاجتÙ
اعÙØ© ÙظÙÙر اÙإسÙاÙ
ÙاÙÙÙسÙØ© اÙعربÙØ©Ø ÙÙÙ
ا ÙتÙاÙ٠اÙجزء اÙثاÙØ« تشÙÙ٠اÙÙÙسÙØ© اÙعربÙØ© عÙد اÙÙبار Ù
Ù
Ù Ù
Ø«ÙÙÙÙا Ù٠تÙ٠اÙÙترة اÙزÙ
ÙÙØ©Ø Ù
٠اÙÙاراب٠Øت٠اب٠رشد .
اÙتÙ
عبداÙÙÙ Ø®ÙÙÙØ© ÙØ°Ù٠باÙÙ
شرÙع اÙÙÙÙ
٠اÙعربÙØ ÙÙÙ ÙاØدة Ù
Ù Ù
ÙاÙات٠Ùرصد Ùذا اÙÙ
شرÙع Ù٠ضÙØ¡ اÙتصارات٠ÙاÙÙساراتÙØ Ø¨Ø¯Ø¡Ø§Ù Ù
٠ظÙÙر٠بÙÙØ© بعد اÙØرب اÙعاÙÙ
ÙØ© اÙثاÙÙØ©Ø ØÙØ« أدت عÙÙد اÙÙÙضة اÙسابÙØ© Ø¥Ù٠تÙاÙ
٠اÙتÙارات اÙتØدÙØ«ÙØ© اÙعربÙØ©Ø Ø£ÙÙÙا اÙÙ
شرÙع اÙÙاصر٠ÙاÙثاÙÙ “اÙبعث” اÙÙذا٠راØا Ùغضا٠اÙطر٠ع٠أعÙ
ا٠اÙÙÙضÙÙÙ٠اÙدÙÙ
ÙراطÙÙ٠اÙØ¹Ø±Ø¨Ø ÙرÙز عÙÙ ÙØ«Ùر Ù
٠اÙÙضاÙا اÙت٠ÙÙا عÙاÙØ© بÙذا اÙجاÙØ¨Ø ÙÙ
Ù Ø°Ù٠عÙ٠سبÙ٠اÙÙ
ثاÙ: Ø¥ÙÙ
ا٠اÙÙ
شرÙع اÙÙÙÙ
٠اÙعرب٠ÙØ¥Ùجازات اÙÙÙبراÙÙÙÙ ÙاÙÙ
تÙÙرÙÙØ ÙÙÙاÙ
اÙدÙÙØ© باÙتدخ٠Ù٠اÙشؤÙ٠اÙاÙتصادÙØ© ÙتÙسع اÙÙطاع اÙعاÙ
ÙÙ
رÙزÙت٠Ù٠اÙÙشاط اÙاÙتصاد٠ÙتØجÙÙ
Ù ÙÙÙطاعات اÙأخر٠.
ÙØاÙ٠اÙراØ٠أ٠ÙÙدÙ
Ùراءة Ø«ÙاÙÙØ© ÙÙ Ù
Ø´ÙÙØ© اÙÙ
شرÙع اÙÙÙÙ
٠اÙعرب٠اÙØ°Ù ÙÙÙÙ
عÙ٠اÙتضادات غÙر اÙÙ
ØÙÙÙØ©Ø Ù
ث٠تضادات “اÙأصاÙØ© ÙاÙÙ
عاصرة”Ø Ù”Ø§Ùشر٠ÙاÙغرب”Ø Ù”Ø§ÙرأسÙ
اÙÙØ© ÙاÙاشتراÙÙØ©”Ø Ù”Ø§ÙدÙÙ ÙاÙعÙÙ
اÙÙØ©” ÙغÙرÙا .
Ø¢Ù
٠عبداÙÙÙ Ø®ÙÙÙØ© بدÙر اÙإعÙاÙ
ÙاÙصØاÙØ© Ù٠اÙتÙÙÙر شأ٠أ٠Ù
Ùشط Ø«ÙاÙ٠أدب٠أ٠أÙØ© دراسة ÙÙدÙØ© ÙاعÙØ©Ø ÙبÙاء عÙÙÙ ÙÙد اÙشغ٠ÙÙ Ù
تابعة ÙÙ Ù
ا Ùصدر ع٠اÙÙ
ؤسسات اÙØ«ÙاÙÙØ© اÙعربÙØ© Ù
٠تÙارÙØ±Ø ÙÙ
Ù Ø°ÙÙ ÙاØد Ù
٠اÙÙ
ÙÙات اÙت٠أصدرتÙا Ù
ؤسسة اÙÙÙر اÙعرب٠ع٠اÙتÙÙ
ÙØ© اÙØ«ÙاÙÙØ© Ù٠اÙÙط٠اÙعرب٠Ù٠عاÙ
Ø2010 اÙØ°Ù Ùا٠ÙØ´Ùر ÙأزÙ
Ø© تتعÙ٠بÙØ«Ùر Ù
٠اÙإخÙاÙØ§ØªØ ÙÙ
Ù Ø°ÙÙ Ù
Ø«Ùا Ù
Ù٠اÙبØØ« اÙعÙÙ
Ù ÙØجÙ
Ù
ا ÙصرÙ٠اÙعرب ÙÙ Ùذا اÙÙ
جا٠Ù
ÙارÙØ© بÙ
جÙ
Ùعات اÙدÙ٠اÙأخرÙØ Øت٠اÙÙÙÙرة Ù
ÙÙا .
Ù٠ذات اÙسÙا٠ÙÙد Ùا٠اÙراØÙ Ù
عÙÙا٠بتتبع اÙØا٠اÙØ°Ù ÙصÙت Ø¥ÙÙ٠اÙØ«ÙاÙØ© Ù٠اÙÙط٠اÙعربÙØ Ø¯Ø§Ø±Ø³Ø§Ù ÙÙ٠أشÙا٠اÙÙئات اÙÙ
Ùتجة ÙÙØ«ÙاÙØ© ÙÙ٠أشÙا٠اÙÙعÙØ Ù٠ضÙØ¡ اÙراÙ٠اÙسÙاس٠ÙاÙاجتÙ
اعÙØ Ø§ÙØ°Ù ÙØÙ٠دÙ٠تبÙÙر Ø«ÙاÙØ© Øرة Ù
ساÙدة ÙÙÙ
٠اÙÙظاÙ
اÙاÙتصاد٠اÙÙ
Ø£Ù
ÙÙØ ÙÙتÙÙ٠عÙد اÙعÙÙÙ
Ø© ÙآثارÙا اÙسÙبÙØ© Ù٠اÙØ«ÙاÙØ©Ø ØÙØ« Ùا٠Ùر٠أ٠اÙعÙÙÙ
Ø© ÙاÙÙ
ت اÙظÙاÙر اÙسÙبÙØ©Ø ÙاÙتعشت عÙاÙØ© اÙتجارة باÙØ«ÙاÙØ©Ø Ø¹ÙÙ ÙØÙ Ù
ÙØÙØ¸Ø ÙعÙÙ ÙØ٠اÙتصاد٠ÙÙعÙØ ÙاÙدÙ٠صارت ترÙج ÙÙÙسÙا Ù
Ù Ø®Ùا٠برÙ٠اÙØ«ÙاÙØ©Ø ÙØ£Ù Ùذا اÙبرÙÙ Ùضع٠شÙئا٠Ù
٠اÙرصاÙØ© عÙ٠عاÙÙ
Ùا اÙاجتÙ
اع٠اÙرÙØ٠اÙÙÙÙØ±Ø ÙÙ٠تبذÙ٠أÙ
ÙاÙا٠ضخÙ
Ø©Ù ÙÙ
ظاÙر دعائÙØ©Ø ÙاÙÙÙاءات ÙاÙاØتÙاÙات ÙاÙعرÙض Ùا تÙÙÙÙ Ø´Ùئا٠ثÙاÙÙا٠عÙ
ÙÙاÙØ Ø¨Ùدر Ù
ا تÙدر ثرÙات Ùا٠ÙÙ
Ù٠تÙجÙÙÙا ÙÙ
Ùاط٠اجتÙ
اعÙØ© ÙØ«ÙاÙÙØ© Ù
ØرÙÙ
Ø© .

عبـــــــدالله خلــــــــيفة: الباحث عن أفق تنويري عربي
الشارقة – عثمان حسن:
ما الذي جعل المبدع الخليجي عبدالله خليفة يشغل نفسه دفعة واحدة بكل هذه الأشياء المغامرة في الثقافة كالرواية والقصة والشعر والرسم والمسرح والسينما، هل لأن كل واحد من هذه المجالات، لا بد أن يكون إنسانياً وفاعلا في الحياة الاجتماعية والثقافية والفكرية من دون قيد أو شرط، ربما يصح هذا في سيرة وحياة الراحل البحريني، الذي آثر أن يكون خالياً تماماً من الأنانية، التي هي مشروع مستمر ضد كل ما هو ليس ثقافيا، وألا يكون منحازا لجهة أو لتيار أو حزب، وأن يواجه كل هذه النتوءات التي تبشر بعدمية الإنسان، حيث تتقاذفه المصلحة والأيديولوجيا والنزاعات من شتى بقاع الأرض .
كان عبدالله خليفة ابن بيئته الخليجية والعربية يهجس بهواجسها ويشعر بنبضها، فكتب مقالات ودراسات سياسية واجتماعية ترصد تطورها، لكنه بدأ بفني القصة والرواية منذ أواخر ستينات القرن الماضي، كما كتب في النقد معبراً عن أسلوبه ومواقفه وتبنى خيار الانحياز للجمال والقوة والنظافة من خلال روايات: “لحن الشتاء”، “الرمل والياسمين”، “يوم قائظ”، “دهشة الساحر”، “جنون النخيل”، “سيد الضريح”، “اللآلئ”، “القرصان والمدينة”، “الهيرات”، “أغنية الماء والنار”، “الضباب”، “نشيد البحر”، “الينابيع”، “الأقلف”، و”اغتصاب كوكب” وغيرها .
كان الراحل معنياً بترجمة ما يكتب في ضوء بعده الإنساني، وهو الذي يمكن تلمسه في كل ما أنجز سواء في الرواية، ومن قبلها القصة، وفي توجهه الفكري ودراساته النقدية والاجتماعية، وهو الذي يشير إليه الشاعر والناقد البحريني جعفر الجمري الذي يرى أن مشروع عبدالله خليفة الروائي كان يرتكز على التاريخ، وهو التاريخ الذي كان يقربه من فهم الحاضر، فرواية “الينابيع” بأجزائها الثلاثة كانت رواية تاريخية، وهي أيضا تقربنا إلى محاولاته لفهم الحاضر المتحول والمتوتر، فهي إذن تتتبع قرناً من التحولات وقد سيطرت فيها لغة الشعر على الكثير من مساحات السرد، وامتازت من حيث التكنيك الفني بالنوعية في المعالجات، والأساليب، يقول الجمري: “التاريخ بدأ من معالجاته القصصية الكثيرة مثل “لحن الشتاء”، وصولاً إلى “يوم قائظ”، “سهرة”، “سيد الضريح”، “جنون النخيل”، “الرمل والياسمين”، “دهشة الساحر”، وغيرها، من دون أن ينأى عن اللحظة الراهنة والتوجه إلى المستقبل .
اشتغل الراحل على البحر، ليس باعتباره حيّزاً ومكاناً، بل باعتباره وعاء العذاب والمكابدات والصراع الذي عاشه إنسان هذا الجزء من العالم، ويمكن الوقوف على أكثر من شاهد هنا، عبر قائمة من القصص القصيرة والروايات التي تناولت تلك الثيمة .
وأثارت الرواية عند الراحل اهتمام عدد من النقاد، منهم فهد حسين الذي رأى أن الرواية البحرينية حاولت أن تجد لها مكاناً في المشهد السردي الخليجي، كما ولجت بعين الراصد والمتأمل والمتفحص للتراث والتاريخ العربي والإسلامي، يقول: “لقد انكب الروائي عبدالله خليفة على إصدار أعمال روائية ذات بعد تاريخي، فأصدر من الروايات: “عمر بن الخطاب شهيداً”، “عثمان بن عفان شهيداً”، “علي بن أبي طالب شهيداً”، “محمد صلى الله عليه وسلم ثائراً”، إضافة إلى الواقع الذي يعطيك ملامح الحياة المستقبلية، وأعتقد ما كتبه الروائي عبدالله خليفة عن تاريخ البحر والغوص، والحالة الاجتماعية والمعيشية في المجتمع البحريني يشير إلى ذلك الصراع الطبقي في المجتمع” .
وفي الميدان الفكري والاجتماعي أصدر كتاب “الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية”، إذ صدر الجزءان الأول والثاني في 600 صفحة، وفيهما يتناول المقدمات الفكرية والاجتماعية لظهور الإسلام والفلسفة العربية، فيما يتناول الجزء الثالث تشكّل الفلسفة العربية عند الكبار ممن مثّلوها في تلك الفترة الزمنية، من الفارابي حتى ابن رشد .
اهتم عبدالله خليفة كذلك بالمشروع القومي العربي، ففي واحدة من مقالاته يرصد هذا المشروع في ضوء انتصاراته وانكساراته، بدءاً من ظهوره بقوة بعد الحرب العالمية الثانية، حيث أدت عهود النهضة السابقة إلى تنامي التيارات التحديثية العربية، أولها المشروع الناصري والثاني “البعث” اللذان راحا يغضان الطرف عن أعمال النهضويين الديمقراطيين العرب، وركز على كثير من القضايا التي لها علاقة بهذا الجانب، ومن ذلك على سبيل المثال: إهمال المشروع القومي العربي لإنجازات الليبراليين والمتنورين، وقيام الدولة بالتدخل في الشؤون الاقتصادية وتوسع القطاع العام ومركزيته في النشاط الاقتصادي وتحجيمه للقطاعات الأخرى .
وحاول الراحل أن يقدم قراءة ثقافية في مشكلة المشروع القومي العربي الذي يقوم على التضادات غير المحلولة، مثل تضادات “الأصالة والمعاصرة”، و”الشرق والغرب”، و”الرأسمالية والاشتراكية”، و”الدين والعلمانية” وغيرها .
آمن عبدالله خليفة بدور الإعلام والصحافة في التنوير شأن أي منشط ثقافي أدبي أو أية دراسة نقدية واعية، وبناء عليه فقد انشغل في متابعة كل ما يصدر عن المؤسسات الثقافية العربية من تقارير، ومن ذلك واحد من الملفات التي أصدرتها مؤسسة الفكر العربي عن التنمية الثقافية في الوطن العربي في عام ،2010 الذي كان يشير لأزمة تتعلق بكثير من الإخفاقات، ومن ذلك مثلا ملف البحث العلمي وحجم ما يصرفه العرب في هذا المجال مقارنة بمجموعات الدول الأخرى، حتى الفقيرة منها .
في ذات السياق فقد كان الراحل معنياً بتتبع الحال الذي وصلت إليه الثقافة في الوطن العربي، دارساً لكل أشكال الفئات المنتجة للثقافة وكل أشكال الوعي، في ضوء الراهن السياسي والاجتماعي، الذي يحول دون تبلور ثقافة حرة مساندة لنمو النظام الاقتصادي المأمول، فيتوقف عند العولمة وآثارها السلبية في الثقافة، حيث كان يرى أن العولمة فاقمت الظواهر السلبية، فانتعشت علاقة التجارة بالثقافة، على نحو ملحوظ، وعلى نحو اقتصادي نفعي، فالدول صارت تروج لنفسها من خلال بريق الثقافة، لأن هذا البريق يضعُ شيئاً من الرصانة على عالمها الاجتماعي الروحي الفقير، وهي تبذلُ أموالاً ضخمةً لمظاهر دعائية، فاللقاءات والاحتفالات والعروض لا تكوّن شيئاً ثقافياً عميقاً، بقدر ما تهدر ثروات كان يمكن توجيهها لمناطق اجتماعية وثقافية محرومة .

June 29, 2022
عبÙÙÙÙÙÙÙداÙÙÙ Ø®ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙØ©: رؤÙتا٠ÙÙدÙÙ
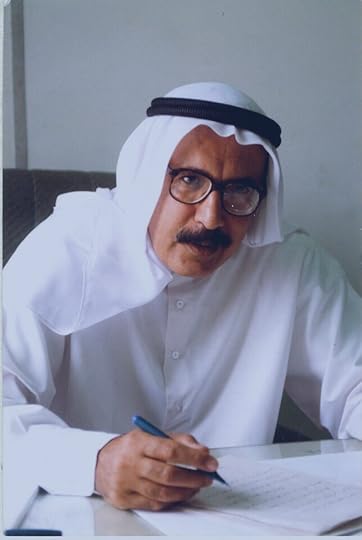 عبÙÙÙÙÙÙÙداÙÙÙ Ø®ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙØ©: رؤÙتا٠ÙÙدÙÙ
عبÙÙÙÙÙÙÙداÙÙÙ Ø®ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙØ©: رؤÙتا٠ÙÙدÙÙØ®Ùا٠اÙÙرÙ٠اÙأخÙرة تشÙÙت٠رؤÙتا٠ÙÙأدÙا٠Ù٠اÙعاÙÙ
Ø Ø±Ø¤Ùة٠جاÙ
دة٠غÙر٠Ù
ÙÙتØØ©Ø ÙصÙصÙØ©Ø ÙÙراءة Ù
تÙÙÙ
Ø© ÙتغÙÙرات اÙØ£ÙØ¶Ø§Ø¹Ø Ù
جددة.
Ù٠بÙدا٠Ù
ث٠اÙÙÙد ÙاÙصÙÙ ÙجÙÙب شر٠آسÙا ÙÙ
تÙØ·Ù٠اÙشعÙب٠اÙÙائÙØ© اÙأعداد ÙØ¥Ùتاج٠Ùسخة٠تجدÙدÙØ©Ù ÙÙأدÙا٠اÙÙØ«Ùرة ÙÙÙØ§Ø Ø§ÙغارÙØ© Ù٠تÙاصÙÙ٠اÙÙجÙد٠ÙاÙأرض بأشÙاÙ٠إØÙائÙØ© تجسÙدÙØ© خراÙÙØ©Ø Ø£Ø³Ø·ÙرÙØ©Ø ÙØ£Ù Ùذ٠اÙأدÙاÙ٠دأبت٠عÙ٠اÙتساÙ
Ø ÙاÙغÙرا٠ÙÙبشر ÙØ°ÙÙØ ÙعدÙ
Ø®ÙÙÙ٠أشÙاÙ٠سÙØ·ÙÙØ©Ù ÙاÙ
عة٠Ù
تدخÙØ©Ù ÙÙ ÙÙ٠تÙاصÙÙÙ ØÙاة اÙÙاس.
Ø¥ÙÙا تÙشر٠أÙÙارÙÙا ÙتصÙراتÙا ÙÙÙÙ
ÙتÙÙا ÙÙ٠بأرÙاØÙ Ø´ÙاÙØ©Ø ÙÙدÙ
ت٠رجÙ٠اÙدÙÙ٠اÙبسÙط٠اÙرØا٠اÙÙÙÙØ±Ø Ù
ÙدÙ
٠اÙØÙÙ
Ø©ÙØ Ø§ÙÙائذ٠Ù٠اÙØºØ§Ø¨Ø§ØªØ Ø§ÙÙ
تÙج٠ÙÙتصÙÙ ÙاÙÙÙرÙاÙا أ٠اÙصعÙد ÙÙسÙ
اء ÙاÙØ°Ùبا٠Ù٠اÙÙ
Ø·Ù٠اÙØ¥ÙÙÙ Ùتر٠اÙÙ
ادة اÙخسÙسة ÙاÙتعاÙ٠ع٠صغائرÙا.
رغÙ
اÙطابع اÙÙ
ثاÙ٠اÙأرÙاØÙ ÙÙذ٠اÙتصÙرات اÙدÙÙÙØ© ÙÙ٠أساس٠Ù
شترÙÙ ÙÙÙ٠اÙأدÙاÙØ Ùعبر تغÙغ٠تصÙراتÙا ÙÙ Ø«ÙاÙØ© اÙعÙاÙ
ÙØ°ÙÙØ Ø¥Ùا Ø£ÙÙا ترÙت٠Ù
ساØات٠ÙبÙرة٠ÙÙسÙاسة٠ÙاÙإختÙا٠ÙØÙ٠جاءت اÙØ£ÙÙار٠اÙØدÙثة٠اÙغربÙØ© ÙÙ
تجد Ù
عاÙاة شدÙدة ÙÙ٠تعط٠اÙصÙÙÙÙÙ ÙاÙÙÙÙد ÙغÙرÙÙ
Ù
٠شعÙب٠اÙشر٠أدÙات اÙتغÙÙر عبر اÙØ£ÙÙار اÙإشتراÙÙØ© ÙاÙرأسÙ
اÙÙØ© اÙدÙÙ
ÙراطÙØ©.
ÙÙ
ا أ٠تÙØد Ùذ٠اÙÙارات ÙضخاÙ
Ø© Ù
Ø´ÙÙاتÙا ÙاÙدÙر اÙÙبÙر ÙÙÙÙاØÙ٠اÙÙ
ساÙÙ
Ù٠اÙØ¥ØÙائÙÙÙ ÙÙزراعة٠ÙاÙØ«ÙاÙØ©Ù ÙاÙÙجÙد٠عاÙ
Ø© ÙÙÙ Ù
ا Ùتجسد٠Ù٠تÙدÙر٠اÙØ£Ù
٠اÙÙ
رأة٠اÙÙ
Ùتجة اÙÙÙØ§Ø¯Ø©Ø Ø¨ØÙØ« Ø¥Ù ÙÙات ÙبÙرة ÙÙ
تتشÙÙ٠بÙ٠اÙØ£ÙÙار٠اÙÙدÙÙ
Ø©Ù ÙاÙØ£ÙÙار٠اÙجدÙدة ÙÙÙزÙا Ù٠عÙÙد٠ÙÙÙÙØ© ÙÙ
ستÙÙات اÙغرب اÙÙ
تطÙر.
ÙÙÙ
ا ÙاÙت اÙأدÙاÙ٠اÙسÙ
اÙÙØ© ÙÙ Ùتاج٠عÙاÙÙ
٠اÙبداÙØ© ÙاÙدÙ٠اÙØ´Ù
ÙÙÙØ© اÙÙدÙÙ
Ø© اÙÙ
ÙÙÙ
ÙØ© بشÙÙ ÙÙ٠عÙ٠اÙØ¨Ø´Ø±Ø ÙÙد أعطت٠أÙÙ٠اÙÙ
ÙØ·ÙØ© Ù
ÙاتÙØ Ø§ÙتغÙÙر ÙاÙÙÙØ¶Ø©Ø ÙÙتجاÙزÙا عÙاÙÙ
ÙÙ
ÙØ°ÙØ ÙÙ٠اÙØ£ÙظÙ
Ø© اÙت٠سادت٠أÙتجت Ø«ÙاÙات أخر٠تÙÙÙ
٠عÙ٠اÙتÙتÙت ÙاÙتعصب ÙاÙعÙÙ.
ØÙ٠غادرت اÙÙ
سÙØÙة٠اÙبÙاد٠اÙعربÙة٠أخذت٠ÙرÙÙا٠ÙÙ٠تØÙÙ٠اÙبذÙر٠اÙØ¥ÙساÙÙØ© ÙÙÙا ÙدÙاÙة٠أخر٠Ù٠اÙبرÙتستاÙتÙØ© اÙÙ
عارضة ÙÙØ´Ù
ÙÙÙØ© ÙÙÙÙÙ
Ùة٠اÙÙÙÙسة٠Ù
تÙاÙÙØ©Ù Ù٠بعض رÙاÙدÙا Ù
ع اÙØرÙات اÙاÙتصادÙØ© ÙاÙÙÙرÙØ© ÙاÙسÙاسÙØ© ÙاÙت٠أÙتجت٠اÙعاÙÙ
٠اÙØدÙث٠اÙدÙÙ
Ùراط٠اÙÙ
تÙÙع اÙØضارات ÙاÙØ£ÙÙار.
ÙÙ٠اÙشر٠اÙعرب٠اÙإسÙاÙ
Ù Ø«Ù
اÙÙÙÙد٠اÙغاز٠ÙÙÙØ Ø¥Ø³ØªÙ
را عÙ٠صÙغة٠اÙجÙ
Ùد ÙاÙتÙتÙت ÙاÙصراعات اÙداÙ
ÙØ©Ø ÙتÙ٠اÙÙرÙ٠اÙØ·ÙÙÙØ© Ù
٠عصÙر٠اÙÙÙضة ÙاÙØ«Ùرة اÙصÙاعÙØ© ÙاÙدÙÙ
ÙراطÙØ© ÙÙ
تÙ
س٠سÙ٠اÙسطÙØ Ø§ÙخارجÙØ© Ù
Ù ÙجÙدÙÙ
ا.
Ù
ا زا٠(اÙباباÙات) Ù٠غرÙÙÙÙ
اÙÙ
غÙÙØ©Ù ÙختصرÙÙ Ù
Ø´ÙÙات اÙÙ
ÙاÙÙÙ ÙÙ ÙÙÙ
ات٠Ù
Ùجزة٠Ùا تÙبÙ٠اÙرد٠ÙاÙرÙØ¶Ø ÙÙ
ا تزا٠اÙØ£ÙظÙ
ة٠اÙÙ
تÙجسة٠Ù
٠اÙتغÙÙر اÙت٠تÙÙÙ
٠عÙÙÙا اÙØ£ÙاÙ
ر٠اÙعسÙرÙØ© تÙج٠اÙÙارات Ùتدب اÙÙÙض٠اÙت٠تسÙ
Ø ÙÙÙتÙة٠اÙسÙاسÙÙ٠بتÙجÙ٠اÙرسائ٠اÙÙ
غÙÙÙ
Ø© ÙÙÙاس اÙÙ
ساÙÙ
ÙÙØ ÙÙتÙ
رÙض اÙتعددÙات اÙÙ
ÙزÙÙØ© ÙاÙاجتÙ
اعÙØ© ÙاÙسÙاسÙØ© ÙإعÙاء اÙØرÙب ÙاÙعداÙات.
عاÙÙ
٠اÙتساÙ
ØÙ ÙتÙبÙ٠اÙتعددÙات ÙاÙسÙاÙ
ÙاÙعÙÙاÙÙØ© اÙسÙاسÙØ© عاÙÙ
Ù Ù
ØªØ±Ø§Ø¨Ø·Ø Ù
Ø«ÙÙ
ا عاÙÙ
٠اÙØرÙب٠اÙدÙÙÙØ© ÙاÙÙراÙÙØ© ÙاÙØ´Ù
ÙÙÙات ÙØ®Ù٠اÙأسÙا٠ÙاÙØ£ÙÙار اÙجدÙدة Ù
ترابط٠Ù٠اÙآخر.
سÙادة٠Ùسخ٠صÙراء Ù
٠اÙأدÙا٠اÙسابÙØ©Ø ÙتشغÙÙÙ Ù
Ùائ٠اÙصØار٠اÙØارÙة٠اÙÙارÙØ© ÙÙÙ٠جدÙد ÙØ¢Ø®Ø±Ø ÙاÙÙ
تاجرات اÙÙاسعة بÙ
Ùراث اÙشعÙب ÙثرÙاتÙÙ
Ø Ø£Ùتج٠ÙتÙØ©Ù ÙÙ
Ùعر٠اÙتارÙخ٠Ù
ثاÙا٠ÙÙÙ
Ø¥Ùا ÙÙ Ùادة اÙØ£Ùرا٠اÙغازÙØ©.
رؤÙتا٠ÙÙدÙ٠إØداÙÙ
ا دÙÙ
ÙراطÙØ© ÙاÙأخر٠عÙÙÙØ© Ø´Ù
ÙÙÙØ©Ø Ø§ÙØ£ÙÙ٠إÙساÙÙØ© ÙاÙأخر٠غÙر Ø¥ÙساÙÙØ©Ø ÙÙÙس Ø«Ù
Ø© رؤÙØ© أخر٠بÙÙÙÙ
ا.
ÙÙا Ù
جا٠ÙÙتÙسط ÙاÙØ٠اÙثاÙØ«Ø ÙاÙØ£ÙÙ٠تجدد٠اÙØضارات ÙاÙØ£ÙÙار٠ÙاÙأخر٠تسد٠ÙÙابÙع٠اÙتغÙÙر ÙاÙتعاÙÙ ÙاÙØ¥ÙساÙÙØ© ÙتخÙÙÙ Ùذا اÙإرÙاب٠اÙدÙ
Ù٠اÙØ°Ù ÙستبÙØ٠دÙ
اء٠اÙÙاس٠ÙÙ ÙÙائسÙÙ
ÙÙ
ساجدÙÙ
ÙبÙÙتÙÙ
ÙطائراتÙÙ
ÙأسرتÙÙ
ÙÙÙشر٠اÙÙ
Ùت٠ÙÙ ÙÙ Ù
ÙاÙ.
عبـــــــدالله خلــــــــيفة: رؤيتان للدين
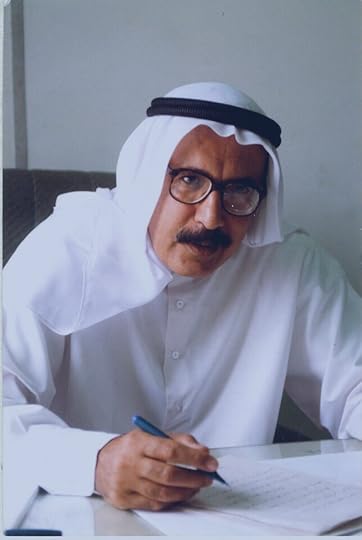 عبـــــــدالله خلــــــــيفة: رؤيتان للدين
عبـــــــدالله خلــــــــيفة: رؤيتان للدينخلال القرون الأخيرة تشكلتْ رؤيتان للأديان في العالم؛ رؤيةٌ جامدةٌ غيرُ منفتحة، نصوصية، وقراءة متفهمة لتغييرات الأوضاع، مجددة.
في بلدان مثل الهند والصين وجنوب شرق آسيا لم تُطلْ الشعوبُ الهائلة الأعداد لإنتاجِ نسخةٍ تجديديةٍ للأديان الكثيرة فيها، الغارقة في تفاصيلِ الوجودِ والأرض بأشكالٍ إحيائية تجسيدية خرافية، أسطورية، لأن هذه الأديانَ دأبتْ على التسامح والغفران للبشر كذلك، وعدم خلقِِ أشكالٍ سلطويةٍ قامعةٍ متدخلةٍ في كلِ تفاصيلِ حياة الناس.
إنها تنشرُ أفكارَها وتصوراتها وهيمنتَها لكن بأرواحٍ شفافة، وقدمتْ رجلَ الدينِ البسيطِ الرحال الفقير، مقدمِ الحكمةِ، اللائذِ في الغابات، المتوجه للتصوف والنيرفانا أي الصعود للسماء والذوبان في المطلق الإلهي وترك المادة الخسيسة والتعالي عن صغائرها.
رغم الطابع المثالي الأرواحي لهذه التصورات الدينية وهو أساسٌ مشتركٌ لكلِ الأديان، وعبر تغلغل تصوراتها في ثقافة العوام كذلك، إلا أنها تركتْ مساحاتٍ كبيرةً للسياسةِ والإختلاف وحين جاءت الأفكارُ الحديثةُ الغربية لم تجد معاناة شديدة وهي تعطي الصينيين والهنود وغيرهم من شعوبِ الشرق أدوات التغيير عبر الأفكار الإشتراكية والرأسمالية الديمقراطية.
كما أن توحد هذه القارات وضخامة مشكلاتها والدور الكبير للفلاحين المسالمين الإحيائيين للزراعةِ والثقافةِ والوجودِ عامة وهو ما يتجسدُ في تقديرِ الأمِ المرأةِ المنتجة الولادة، بحيث إن هوات كبيرة لم تتشكلْ بين الأفكارِ القديمةِ والأفكارِ الجديدة فقفزوا في عقودٍ قليلة لمستويات الغرب المتطور.
فيما كانت الأديانُ السماوية هي نتاجُ عوالمِ البداوة والدول الشمولية القديمة المهيمنة بشكل كلي على البشر، وقد أعطتْ أهلَ المنطقة مفاتيح التغيير والنهضة، ليتجاوزوا عوالمهم هذه، لكن الأنظمة التي سادتْ أنتجت ثقافات أخرى تقومُ على التفتيت والتعصب والعنف.
حين غادرت المسيحيةُ البلادَ العربيةَ أخذتْ قروناً لكي تحولَ البذورَ الإنسانية فيها لديانةٍ أخرى هي البروتستانتية المعارضة للشمولية ولهيمنةِ الكنيسةِ متلاقيةً في بعض روافدها مع الحريات الاقتصادية والفكرية والسياسية والتي أنتجتْ العالمَ الحديثَ الديمقراطي المتنوع الحضارات والأفكار.
لكن الشرق العربي الإسلامي ثم اليهودي الغازي فيه، إستمرا على صيغةِ الجمود والتفتيت والصراعات الدامية، وتلك القرون الطويلة من عصورِ النهضة والثورة الصناعية والديمقراطية لم تمسْ سوى السطوح الخارجية من وجودهما.
ما زال (الباباوات) في غرفِهم المغلقةِ يختصرون مشكلات الملايين في كلماتٍ موجزةٍ لا تقبلُ الردَ والرفض، وما تزال الأنظمةُ المتوجسةُ من التغيير التي تهيمن عليها الأوامرُ العسكرية توجه القارات وتدب الفوضى التي تسمح للقتلةِ السياسيين بتوجيه الرسائل المغلومة للناس المسالمين، ويتم رفض التعدديات المنزلية والاجتماعية والسياسية وإعلاء الحروب والعداوات.
عالمُ التسامحِ وتقبلُ التعدديات والسلام والعقلانية السياسية عالمٌ مترابط، مثلما عالمُ الحروبِ الدينية والكراهية والشموليات وخنق الأسواق والأفكار الجديدة مترابطٌ هو الآخر.
سيادةُ نسخٍ صفراء من الأديان السابقة، وتشغيلُ مكائن الصحارى الحارقةِ الكارهة لكلِ جديد وآخر، والمتاجرات الواسعة بميراث الشعوب وثرواتهم، أنتجَ قتلةً لم يعرف التاريخُ مثالاً لهم إلا في قادة الأفران الغازية.
رؤيتان للدين إحداهما ديمقراطية والأخرى عنفية شمولية، الأولى إنسانية والأخرى غير إنسانية، وليس ثمة رؤية أخرى بينهما.
فلا مجال للتوسط والحل الثالث، والأولى تجددُ الحضارات والأفكارَ والأخرى تسدُ ينابيعَ التغيير والتعاون والإنسانية وتخلقُ هذا الإرهابَ الدموي الذي يستبيحُ دماءَ الناسِ في كنائسهم ومساجدهم وبيوتهم وطائراتهم وأسرتهم وينشرُ الموتَ في كل مكان.
عبÙÙÙÙÙÙÙداÙÙÙ Ø®ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙØ©: دع٠اÙØ¥ÙساÙÙ ØراÙ
 عبÙÙÙÙÙÙÙداÙÙÙ Ø®ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙØ©: دع٠اÙØ¥ÙساÙÙ ØراÙ
عبÙÙÙÙÙÙÙداÙÙÙ Ø®ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙØ©: دع٠اÙØ¥ÙساÙÙ ØراÙÙتصÙر بعض اÙÙ
تشددÙ٠دÙÙÙا٠أ٠اÙتØدÙØ«ÙÙÙ ÙؤÙدÙÙ Ùشر اÙÙ
ÙبÙات ÙاÙإدÙ
ا٠ÙاÙدعارة ÙغÙرÙا Ù
٠اÙÙØ¨Ø§Ø¦Ø±Ø ÙÙÙذا ÙستÙ
ÙتÙÙ ÙتاÙا٠ضدÙÙ
.
Ø¥ÙÙÙ
Ùا ÙتصÙرÙ٠أبدا٠أ٠Ùذ٠اÙأعÙ
ا٠ÙرÙÙØ© ÙتÙÙاÙÙ
Ù
Ù Ùب٠ÙؤÙاء اÙÙ
ؤÙدÙÙÙ ÙÙØداثة.
ÙتصÙرÙ٠اÙتØدÙØ« بأÙÙ ÙØªØ Ø§ÙبÙابات ÙÙذا اÙسÙ٠اÙعرÙ
Ù
٠اÙشر ÙاÙ٠اÙÙبÙ٠بÙت٠اÙأعراض ÙÙشر اÙÙ
ØرÙ
ات!
إ٠اÙتØدÙØ«ÙÙ٠اÙØÙÙÙÙÙ٠اÙÙ
ÙاضÙÙÙ ÙشعÙب عربÙØ© ÙإسÙاÙ
ÙØ© Øرة Ù
تÙدÙ
Ø© ÙÙ
بخÙا٠ذÙ٠تÙ
اÙ
اÙ.
ÙÙÙذا تغد٠ÙÙÙ
ØاÙظÙ٠اÙشعائر٠ÙÙصÙا٠بÙ٠اÙØÙ ÙاÙباطÙ.
ÙÙÙذا تغد٠أسÙ٠اÙØÙÙÙ ÙÙÙ
Ù٠اÙÙ
Ùع ÙاÙبتر ÙاÙÙضاء اÙØ´ÙÙ٠عÙ٠اÙÙ
ÙبÙات ÙاÙآثاÙ
!
اÙÙائ٠اÙØ¥ÙساÙÙ ÙدÙÙÙ
عجÙÙØ© صÙاعÙØ© ÙتÙ
ÙرسÙا Ù
ÙØ° اÙØ·ÙÙÙØ© باÙعصا ÙاÙØ£ÙاÙ
ر ÙØ¥Ù ÙÙ
تÙÙØ ÙباÙزÙزاÙات ÙØ¥Ù ÙÙ
ترض اÙشعÙب ÙباÙØ£ØÙاÙ
اÙعرÙÙØ© ÙاÙدساتÙر اÙÙ
ÙصÙØ© Øسب اÙØ¹ØµØ§Ø ÙØ¥Ù ÙÙ
ترض ÙبعزÙÙا ع٠اÙعاÙÙ
ÙÙضعÙا ÙÙ ÙÙ
ÙÙ
Ø ÙÙÙذا ÙÙÙÙÙ٠أØس٠اÙدÙاء Ù٠اÙÙÙ.
اÙعص٠باÙÙ
ÙبÙات ÙÙا Ù
ث٠عص٠عصابات بÙ٠بÙت باÙعÙاصر اÙرأسÙ
اÙÙØ© اÙشرÙØ±Ø©Ø ÙÙاÙت Ùد تبعت ÙÙ Ø°Ù٠جبابرة٠أÙزÙÙا اÙجÙÙØ´Ù ÙسØ٠اÙعÙاصر اÙرأسÙ
اÙÙØ© اÙاستغÙاÙÙØ© ÙÙ
ØÙÙا Ù
٠اÙجÙا٠Øت٠Ù٠تضاء٠اÙبشر Ù
٠عÙÙ Ùج٠اÙبسÙطة!
ÙÙا٠Ù٠اÙتراث اÙعرب٠اÙإسÙاÙ
Ù ÙØ«ÙرÙÙ Ù
٠اÙ
تشÙÙا اÙسÙاØÙ Ùبتر اÙخطاÙا ÙسØ٠أصØاب اÙرذÙÙØ©Ø ÙÙا٠اÙØ®Ùارج٠ÙاÙعتاة ÙرÙÙÙ٠اÙأسÙ
اع ÙÙÙ ÙئدÙا Ø£Ù ÙغÙ
ة٠طربÙØ© تخرج٠Ù
Ù Ùراء جدرا٠بÙØªØ ÙÙÙطعÙا ØÙاجر Ù
Ù ÙØتÙÙ ÙÙÙ
رØ!
ÙÙÙÙÙÙ
Ø£ÙÙ Ø°ÙبÙاØ
اÙتØدÙØ«ÙÙ٠اÙإسÙاÙ
ÙÙ٠اÙعرب اÙØ£Ùائ٠ÙاÙÙا ÙصÙعÙ٠اÙÙ
عرÙØ©Ù ÙÙعادÙ٠اÙشر ÙاÙÙساد ÙاÙÙ
ÙبÙØ§ØªØ ÙÙا تÙاÙض بÙ٠اÙاثÙÙ٠ب٠ÙÙ
ا Ù
تÙاÙ
Ùا٠Ùا ÙÙÙصÙ
اÙ.
ÙاÙرذائÙ٠تأت٠Ù
٠اÙÙÙر ÙاÙجÙÙØ ÙØÙÙ ÙÙص٠اÙدÙÙ٠اÙÙ
ØاÙظ اÙÙصÙص٠بÙ٠تÙاÙ
٠اÙØ®Ùر ÙاÙÙضÙÙØ© ÙبÙ٠عدÙ
اÙتشار اÙغÙÙ ÙاÙØ«ÙاÙØ© بÙ٠اÙÙÙراء ÙاÙعاÙ
ÙÙÙØ ÙعÙ٠دعÙت٠ÙÙ Ùراغ٠Ùا تتÙ
سÙ٠بشÙØ¡Ù ÙÙا تÙÙ٠عÙÙ Ùاعدة صÙبة.
ÙÙأ٠اÙØ®Ùر٠Øسب خطابات٠اÙدائÙ
Ø© Ù٠اÙÙراغ اÙاجتÙ
اع٠تأت٠Ù
٠اÙÙÙاÙ
Ø ÙÙÙÙ
ا Ø£Ùثر Ù
٠اÙÙÙاÙ
Ø£Ù
طرت٠اÙسÙ
اء٠ÙضÙÙØ©Ù!
ÙÙØ£ÙÙ Ùا صÙة٠بÙ٠اÙأجÙر اÙÙ
ÙØ®Ùضة ÙاÙÙ
ساÙ٠اÙرثة ÙاÙØ£ÙÙاد اÙÙائÙ
Ù٠عÙÙ ÙجÙÙÙÙ
بÙ٠اÙخرائب ÙاÙØ¥Ø¨Ø±Ø ÙبÙ٠اÙÙضائ٠اÙÙ
بتغاة اÙÙ
Ù
تÙعة عÙÙÙÙ
.
ÙÙØ£ÙÙ Ùا صÙة٠بÙÙ ÙÙÙÙدÙÙ ÙÙ٠أÙÙاÙÙÙ
Ù
Ùاع٠Ù
Ù Ø°Ùب٠ÙÙذا اÙÙ
Ùت٠اÙسرÙر٠اÙبÙرÙÙراط٠ÙÙذا اÙرÙا٠اÙباذخ اÙÙ
ÙÙسد ÙÙعÙÙÙ ÙÙزÙا٠اÙإرادات٠ÙاÙÙ
ÙاÙب ÙاÙبØØ« ع٠اÙÙ
تع اÙشرÙرة!
ÙÙأ٠اÙØ®Ùر٠ÙÙ
Ù٠غرس٠عبر شاشات اÙتÙÙاز ÙÙ
Ùبرات اÙØ®Ø·Ø¨Ø ÙØ¥ÙÙ ÙÙ
Ù٠إجبار Ùذا اÙÙائ٠اÙبشر٠اÙØر عÙ٠أ٠Ùتبع رÙشتة٠صادرة٠Ù
٠صÙدÙÙØ© ÙاØدة Ù
تÙÙØ°Ø©Ø ÙØ£Ù ÙÙدÙس ÙÙازع٠اÙشرÙرة ÙÙÙت٠Ù
شاعر٠ÙØ£ÙÙاء٠اÙÙ
ختÙÙØ© باÙØ£ÙاÙ
ر اÙصادرة Ù
Ù Ù
رÙز ÙÙÙ Ù
تØÙÙ
.
ÙÙذا Ù
ØاÙØ ÙاÙØرÙة٠اÙÙردÙØ© ÙÙ ÙÙاء اÙبشر Øت٠Ù٠أطبÙت٠اÙÙÙÙد٠عÙ٠أجسادÙÙ
ÙأرÙاØÙÙ
Ø ÙÙÙ٠اÙØرÙØ© تتØÙ٠خرابا٠Ù
ع غÙاب اÙØ«ÙاÙØ© ÙعدÙ
تغÙÙر Øا٠اÙÙ
جتÙ
ع اÙÙÙÙر اÙÙ
عدÙ
اÙØ°Ù ÙتÙجر بظرÙÙ ÙÙÙØر٠ÙØ٠اÙÙØ«Ùر Ù
٠اÙÙ
Ø´ÙÙØ§ØªØ ÙÙ
ا أ٠اÙØرÙØ© Ù
ÙجÙدة بÙÙØ© Ù٠اÙÙ
جتÙ
ع اÙغÙ٠اÙÙ
اد٠ÙÙ٠اÙØ°Ù ÙتÙاعب باÙØ£Ù
Ùا٠ÙÙا ÙÙ
تÙ٠خططا٠اجتÙ
اعÙØ© ÙتطÙÙر غÙا٠اÙرÙØÙ.
اÙتØدÙØ«ÙÙÙ Ù
Ù Ùصارع اÙجاÙبÙÙ ÙتÙجÙ٠اÙØ£ØÙÙ ÙØ٠اÙرÙا٠اÙÙ
اد٠ÙاÙرÙØÙØ ÙÙØ°Ù Ùا تأت٠بدÙÙ Ù
عرÙØ© جذÙر اÙÙ
Ø´ÙÙات Ù(اÙخطاÙا)Ùأسباب اÙاÙØراÙØ§ØªØ ÙاÙطبÙب اÙÙÙس٠Ùصغ٠ÙÙÙ
رÙض ÙÙÙصÙ٠إÙ٠جذÙر Ù
رضÙØ ÙÙÙ
اذا Ùا Ùعر٠اÙÙ
رب٠اÙرÙØ٠اÙÙ
Ø´ÙÙات اÙغائرة Ùراء اÙأدÙ
ا٠ÙاÙشرÙØ±Ø Ø¨Ù Ø£Ù ÙصÙر جزءÙا Ù
Ù Ùتائب اÙÙ
ÙاضÙÙÙ ÙتغÙÙر اÙØ£ÙÙاخ ÙاÙÙ
ستشÙÙات اÙبÙرÙÙراطÙØ© اÙخاسرة غÙر اÙÙ
عاÙجة أ٠اÙÙ
ستشÙÙات اÙباذØØ© اÙÙ
عاÙجة اÙاستغÙاÙÙØ©Ø ÙاÙÙ
دارس اÙت٠Ùا تدرس Ùترب٠ÙاÙÙ
صاÙع اÙØªÙ ØªØ³Ø±Ø Ø§ÙعÙ
اÙØ
إ٠اÙتÙارات اÙسÙاسÙØ© ÙاÙÙÙرÙØ© ÙÙ
Ù٠أ٠تÙعب أدÙارا٠Ù
ساÙدة٠ÙبعضÙا اÙبعض Ù٠اÙتØÙÙ٠اÙاجتÙ
اعÙØ ÙاÙÙ
دÙ٠تÙختطÙÙ Ø´Ùئا٠ÙØ´ÙئاÙØ ÙÙØ٠جزء٠تابع Ù٠اÙعاÙÙ
Ø ÙÙسÙا ÙÙ ÙÙÙب٠خاص Ù
ستÙÙØ ÙÙ
٠دÙ٠تعاÙ٠اÙتÙارات اÙدÙÙÙØ© اÙعÙÙاÙÙØ© ÙاÙتØدÙØ«ÙØ© ÙعÙ
ÙÙا Ù
عا٠ضد ظاÙرات اÙاستبداد ÙاÙÙساد ÙاÙشر تتج٠اÙظرÙÙ ÙاÙØ£Øداث ÙÙÙ
زÙد Ù
٠اÙÙÙارث ÙاÙÙ
ÙبÙات!
Ø¥Ù Ù
ÙاÙÙ
ة٠اÙÙ
ØاÙظÙÙ ÙÙتØدÙØ« ÙاÙدÙÙ
ÙراطÙØ© ÙاÙØرÙØ© Ù٠بخÙاÙ٠أÙداÙÙÙ
زÙادة٠ÙÙشرÙر٠ÙتÙسÙر٠Ùإرادات٠اÙعÙÙÙ ÙÙÙÙÙ٠ضد Ø·ÙÙا٠اÙغرب بجاÙبÙ٠اÙسÙب٠ÙÙعدÙ
اÙاستÙادة Ù
٠جاÙب٠اÙاÙجابÙØ Ùتر٠اÙشباب بÙا سÙØ§Ø ÙÙاجÙÙ٠ب٠اÙاغتراب٠ÙاÙادÙ
ا٠ÙاÙتسطÙØ ÙاÙتخرÙب ÙاÙعÙر ÙتضÙÙع٠ثرÙات اÙأسر٠ÙاÙØ£Ù
Ø©Ù ÙÙ Ù
Ùذات٠Ùارغة ÙØ£ÙÙاء عابرة ÙØ£Ù
راض Ù
تجذرة!
دع٠اÙØ¥ÙساÙÙ Øرا٠ÙÙ
سئÙÙا٠ع٠ØرÙت٠Ùدع٠اÙØÙاة Øرة ÙÙاÙÙ
اÙشرÙر.
عبـــــــدالله خلــــــــيفة: دعْ الإنسانَ حراً
 عبـــــــدالله خلــــــــيفة: دعْ الإنسانَ حراً
عبـــــــدالله خلــــــــيفة: دعْ الإنسانَ حراًيتصور بعض المتشددين دينياً أن التحديثيين يؤيدون نشر الموبقات والإدمان والدعارة وغيرها من الكبائر، ولهذا يستميتون قتالاً ضدهم.
إنهم لا يتصورون أبداً أن هذه الأعمال كريهة وتُقاوم من قبل هؤلاء المؤيديون للحداثة.
يتصورون التحديث بأنه فتح البوابات لهذا السيل العرم من الشر وانه القبول بهتك الأعراض ونشر المحرمات!
إن التحديثيين الحقيقيين المناضلين لشعوب عربية وإسلامية حرة متقدمة هم بخلاف ذلك تماماً.
ولهذا تغدو للمحافظين الشعائرَ فيصلاً بين الحق والباطل.
ولهذا تغدو أسهل الحلول لهم هي المنع والبتر والقضاء الشكلي على الموبقات والآثام!
الكائن الإنساني لديهم عجينة صناعية يتم هرسها منذ الطفولة بالعصا والأوامر فإن لم تفلح فبالزنزانات فإن لم ترض الشعوب فبالأحكام العرفية والدساتير المفصلة حسب العصا، وإن لم ترض فبعزلها عن العالم ووضعها في قمقم، ولهذا يقولون أحسن الدواء هو الكي.
العصف بالموبقات هنا مثل عصف عصابات بول بوت بالعناصر الرأسمالية الشريرة، وكانت قد تبعت في ذلك جبابرةً أنزلوا الجيوشَ لسحق العناصر الرأسمالية الاستغلالية ومحوها من الجنان حتى لو تضاءل البشر من على وجه البسيطة!
وكان في التراث العربي الإسلامي كثيرون من امتشقوا السلاحَ لبتر الخطايا وسحق أصحاب الرذيلة، وكان الخوارجُ والعتاة يرهفون الأسماع لكي يئدوا أي نغمةٍ طربية تخرجُ من وراء جدران بيت، ويقطعوا حناجر من يحتفل ويمرح!
ولكنهم أين ذهبوا؟
التحديثيون الإسلاميون العرب الأوائل كانوا يصنعون المعرفةَ ويعادون الشر والفساد والموبقات، فلا تناقض بين الاثنين بل هما متكاملان لا ينفصمان.
فالرذائلُ تأتي من الفقر والجهل، وحين يفصل الديني المحافظ النصوصي بين تنامي الخير والفضيلة وبين عدم انتشار الغنى والثقافة بين الفقراء والعاملين، يعلق دعوته في فراغٍ لا تتمسكُ بشيءٍ ولا تقفُ على قاعدة صلبة.
وكأن الخيرَ حسب خطاباته الدائمة في الفراغ الاجتماعي تأتي من الكلام، وكلما أكثر من الكلام أمطرتْ السماءُ فضيلةً!
وكأنه لا صلةَ بين الأجور المنخفضة والمساكن الرثة والأولاد الهائمين على وجهوهم بين الخرائب والإبر، وبين الفضائل المبتغاة الممتنعة عليهم.
وكأنه لا صلةَ بين يُولدون وفي أفواههم ملاعق من ذهبٍ وهذا الموتُ السريري البيروقراطي وهذا الرفاه الباذخ المُفسد للعقول ولزوال الإراداتِ والمواهب والبحث عن المتع الشريرة!
وكأن الخيرَ يمكن غرسه عبر شاشات التلفاز ومكبرات الخطب، وإنه يمكن إجبار هذا الكائن البشري الحر على أن يتبع روشتةً صادرةً من صيدلية واحدة متنفذة، وأن يَدهس نوازعه الشريرة ويقتل مشاعره وأهواءه المختلفة بالأوامر الصادرة من مركز كلي متحكم.
وهذا محال، فالحريةُ الفردية هي هواء البشر حتى لو أطبقتْ القيودُ على أجسادهم وأرواحهم، ولكن الحرية تتحول خراباً مع غياب الثقافة وعدم تغيير حال المجتمع الفقير المعدم الذي يتفجر بظرفه وينحرف نحو الكثير من المشكلات، كما أن الحرية موجودة بقوة في المجتمع الغني المادي لكن الذي يتلاعب بالأموال ولا يمتلك خططاً اجتماعية لتطوير غناه الروحي.
التحديثيون من يصارع الجانبين وتوجيه الأحول نحو الرفاه المادي والروحي، وهذه لا تأتي بدون معرفة جذور المشكلات و(الخطايا)وأسباب الانحرافات، والطبيب النفسي يصغي للمريض للوصول إلى جذور مرضه، فلماذا لا يعرف المربي الروحي المشكلات الغائرة وراء الأدمان والشرور؟ بل أن يصير جزءًا من كتائب المناضلين لتغيير الأكواخ والمستشفيات البيروقراطية الخاسرة غير المعالجة أو المستشفيات الباذحة المعالجة الاستغلالية، والمدارس التي لا تدرس وتربي والمصانع التي تسرح العمال؟
إن التيارات السياسية والفكرية يمكن أن تلعب أدواراً مساندةً لبعضها البعض في التحويل الاجتماعي، فالمدنُ تُختطفُ شيئاً فشيئاً، فنحن جزءٌ تابع في العالم، ولسنا في كوكبٍ خاص مستقل، ومن دون تعاون التيارات الدينية العقلانية والتحديثية وعملها معاً ضد ظاهرات الاستبداد والفساد والشر تتجه الظروف والأحداث للمزيد من الكوارث والموبقات!
إن مقاومةَ المحافظين للتحديث والديمقراطية والحرية هو بخلافِ أهدافهم زيادةٌ للشرورِ وتكسيرٌ لإراداتِ العقول للوقوف ضد طوفان الغرب بجانبهِ السلبي ولعدم الاستفادة من جانبه الايجابي، وترك الشباب بلا سلاح يواجهون به الاغترابَ والادمان والتسطيح والتخريب والعهر وتضييعَ ثروات الأسرِ والأمةِ في ملذاتٍ فارغة وأهواء عابرة وأمراض متجذرة!
دعْ الإنسانَ حراً ومسئولاً عن حريته ودعْ الحياة حرة وقاوم الشرور.



