عبـــــــدالله خلــــــــيفة's Blog: https://isaalbuflasablog.wordpress.com , page 57
September 12, 2022
أشيعة أم شيوعيون؟! : عبـــــــدالله خلــــــــيفة
 #عبدالله_خليفة
#عبدالله_خليفة اختلطت التسميتان في الزمن القديم، كان الكثير من الشيعة في المشرق العربي مضطهدون، وكان الشيوعيون يبحثون عن المضطهدين في العمال والنساء والفقراء عموماً، فتغلغلوا بينهم، وفي ذلك الوقت كان الاتحاد السوفيتي وكانت الثورات الوطنية وصعود العمال ولم تكن ثمة طائفية سياسية معارضة، فكان الشيوعيون فصيل من فصائل التوحيد لا التفريق بين ملل الإسلام المختلفة!
فحين كان الشيوعيون أقرب لفكرهم والشيعة أقرب لمذهبهم توحد المختلفون!
وقد اختلطت الأسماء حيناً فمن يُعتقل وهو شيوعي يقول بأنه شيعي، وهو يحرض على هذا الأساس بين الجمهور، ويتناول رموزاً إسلامية مضطهدة ويعبر بها عن كفاح العمال الحديث!
كانت شعارات عامة تصلح لكل زمان ومكان وهو خيال الفقراء في النضال الوطني وفي الحصول على ظروف جيدة، وهو تقليد قديم بين أهل المنطقة فطالما ركبوا شعارات تحديثية قادمة من أمكنة أخرى ودمجوا بها معاناتهم.
وكانت الشيوعية قوة تغيير وطنية كاسحة كبرى في زمن الاستعمار القديم، فهناك مليارات من البشر في الشرق والغرب وراءها، ولم تتتفهم بأنها مرحلة معينة في تطور الرأسماليات الوطنية الشرقية الدكتاكتورية، وإن إزالة الطبقات وسيادة العمال ما هي سوى أحلام مستقبلية بعيدة.
ولهذا فإن إختلاط هذه الأحلام بالأديان والمذاهب هو أمر عادي في تاريخ الشرق، وكم اختلطت المذاهب الإسلامية بالمانوية والزرادشتية والأرسطية وغيرها وانتجت ظواهر جديدة معارضة وخيالات و.
لكن الأديان والمذاهب تبقى أدياناً ومذاهباً لها مساراتها الخاصة، وإن الظواهر الهجينة التي تنتمي لأجهزة معرفة وكيانات فكرية مختلفة تتفارق آجلاً أم عاجلاً.
وكان خطأ الأوائل هو عدم فهم الأديان والتيارات الفلسفية معاً، فكلٌ له مساره المختلف، وإذا كان ثمة توحدٌ في أشياء ومبادئ معينة فهو يرجعُ لمعاناة البشر عبر العصور والأوطان.
لكن أهل الأرياف الشيعة وخاصة العمال الطليعيين والمثقفين المتنورين وجدوا في المذهب الشيوعي عزفاً على المعاناة وقهر الناس وإستغلالهم، وهو ما كان قوياً عارماً في مذهبهم على المستوى الشعبي لا على مستوى رجال الدين!
وبسبب مستوى معرفتهم الشعاري في المذاهب والفلسفات تبنوا الجانبين!
وكان أغلب هؤلاء محرضين وسيظلون في درجة التحريض طوال حياتهم وهي الدرجة الأولى الدنيا في فهم الفكر الحديث وإذا استمر المرء عليها انتهى منه.
التحريض يتطلب لتجاوزه القراءة العميقة والدرس والفتوى النظرية فيما بعد، وهي عملية مقاربة لفهم النص الديني، الذي يتطلب هذه الدرجات بشكل متصاعد.
وفي سنوات الستينيات خاصة من القرن الماضي تداخلت الأوساط النخبوية من الجانبين الشيعي والشيوعي، فلم تجد في الاختلافات الفكرية كوجود الإله ونفيه أو في الإيمان بيوم القيامة والكتب السماوية، عقبات للعمل المشترك والإيمان المشترك!
كانت محن الناس العاديين وكانت الظروف المشتركة لهؤلاء القياديين العماليين والمثقفين تدفعهم لتجاوز الاختلافات الفكرية.
كما ان الجانبين لا يتغلغلان بشكل عميق في المصطلحات الماركسية أو المذهبية. لكن كانت القيادة بين هذا الخليط تعود للشوعيين بطبيعة الحال فوراءهم دولة كبرى هي الاتحاد السوفيتي وكانوا قادرين على إرسال بعثات دراسية والتصدي في المراكز القيادية للمؤتمرات التي تعقد في أمكنة مختلفة في الكرة الأرضية!
لكن تفارق الجانبين حدث مع تضاؤل الاتحاد السوفيتي خاصة الذي لم يعد قادراً على البذل المادي في سباق التسلح وفي الإنهاك الأمريكي له وفي الصرف الواسع على حركات التحرر.
فقد برز المركزُ الإيراني الشيعي، كقائد عارم للطائفة، ودفع الخصام مع الحركات التقدمية والقومية والإنسانية إلى أبعد مداه، في مشروعه لاستثمار الطائفة العالمية الشيعية لمشروعه القومي الإيراني السياسي.
إن عدم تناغم المركز الإيراني مع الحركات التقدمية العالمية لكونه اعتمد النصوصية الدينية العتيقة، واستبعد جوهر المذهب الشيعي النضالي، وعبر هذه النصوصية وتأجيج العداء لغيرها حاول تكريس سيطرته على ملايين الشيعة في العالم.
وهكذا حدث الانفصال الحاسم بين الشيعة والشيوعية، وخاصة في المراكز السياسية الدينية المحافظة، بينما واصل بعض التقدميين العيش في زمن التحالف القديم، والخلط بين المنهجين، لكون مستوياتهم الفكرية لم تتطور، ليس عبر تكريس العداء للمذاهب الإسلامية، بل لعدم فهمها، ولضرورة فرز المتعصبين والاستغلاليين لتلك المذاهب في مشروعاتهم لسرقة الجماهير المؤمنة، وللتحالف مع الإنسانيين والمناضلين فيها لصالح الجمهور.
وهذه الأسس هي العلمانية والعقلانية والديمقراطية، فلم يعد ممكناً الخلط بين المذاهب والحركات السياسية، ولم يعد ممكناً مزج المبادئ الذي لا يقوم به سوى الأميون والمتخلفون الفكريون.
فالمذهبية السياسية الدينية شيء والماركسية والقومية والليبرالية أشياء أخرى، تتقارب في أعمالها السياسية وتتصارع لكنها لا تذوب في بعضها البعض.
من يرد العودة إلى مذاهبه فليعد ولكن الخلطة الهجينة الفكرية لا تصلح للعصر.
عبـــــــدالله خلــــــــيفة : الولادة العسيرة لليسار الديمقراطي الشرقي
عبـــــــدالله خلــــــــيفة : وعي النهضة عند مهدي عامل
لا شك أن المفكر اللبناني الراحل مهدي عامل من المساهمين البارزين في تحليل الواقع العربي المعاصر من منطلقات نقدية عميقة وخاصة من رافد الماركسية البنيوية، التي قام بتطبيقها على الواقع العربي بصورة حرفية، دون رؤية الاختلاف بين مستوى التطور الغربي، وتطور البُنى الاجتماعية العربية.
ونحاول في هذه الموضوعات قراءة آرائه وتحليلاته لندوة جرت في الكويت في السبعينيات من القرن الماضي، اتخذت لها عنواناً هو ( أزمة التطور الحضاري في الوطن العربي)، وقد ناقشها في كتابه (أزمة الحضارة العربية أم أزمات البرجوازيات العربية ؟)، ونعتمد على الطبعة السابعة للكتاب الصادرة عن دار الفارابي ببيروت سنة2002.
يفترض مهدي عامل مسبقاً، ودون دراسات، بأن المجتمعات العربية هي مجتمعات رأسمالية. فهو يصر على أن ( نمط الإنتاج الرأسمالي المسيطر في البنيات الاجتماعية العربية) ص 16.
إن هذا يبدو لوعيه شيئاً بديهياً، صحيح إنه يقول أن ثمة علاقات ما قبل رأسمالية في هذا الإنتاج غير أنها ليست سوى بقايا.
فيقول بوضوح: إن فهم تطور بنية علاقات الإنتاج الرأسمالية مثلاً في البلدان العربية في الوقت الحاضر، وفهم أزمات هذا التطور يستلزم بالضرورة الانطلاق بالتحليل من هذه البنية بالذات في شكل وجودها القائم في كل من البلدان العربية.)، ص21.
وليس ثمة من الضرورة بحث جذور هذه البُنى ( مع ظهور الإسلام مثلاً، أو مع الجاهلية، أو مع بدء العصر العباسي أو الأموي أو الأندلسي أو عصر الانحطاط الخ…، بل هو يبدأ مع بدء التغلغل الإمبريالي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.)، 21.
وهو يعترف بأن ثمة ( أشكالاً من الإنتاج سابقة على الإنتاج الرأسمالي لا تزال حاضرة في البنيات الاجتماعية العربية )، غير أنها ليست سائدة فيه، بل الإنتاج الرأسمالي هو السائد.
ونحن نحاول أن نفهم كيف استطاع الاستعمار أن يجعل من هذه العلاقات سائدة؟ أي كيف استطاع أن يجعل العلاقات ما قبل الرأسمالية لا تسود بل أن تسود العلاقات الرأسمالية ؟
لا يقوم مهدي عامل ببحث هذه المسألة تاريخياً، بأن يعطينا أمثلة عن بلد عربي ومنذ القرن التاسع عشر تحول إلى الرأسمالية ؟ فلا نجد.
ولا أن يقوم بتحديد متى استطاعت البرجوازيات العربية أن تستولي على الحكم وتنشر النظام الرأسمالي الشامل ؟
ومن جهة أخرى فهو يؤكد بأن (كثيراً من علاقات الإنتاج الاجتماعية، سواء في الحقل الاقتصادي أم السياسي أم الإيديولوجي، التي تنتمي إلى أنماط من الإنتاج بالية، أي بالتحديد، سابقة على الرأسمالية، لا تزال قائمة في البنيات الاجتماعية المعاصرة )، ص 53.
ينطلق مهدي عامل لتحديد هيمنة الرأسمالية على العالم العربي منذ القرن التاسع عشر بشكل مضاد للقراءة الموضوعية، وهو يفترض رأسمالية سحرية تتشكل منذ أن تطأ بوارج بريطانيا وفرنسا الشواطئ العربية، في حين إن الرأسمالية تتعلق بمدى تشكل الرأسمال الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومدى انتشار العمل المأجور على بقية أنواع العمل في النظام الاجتماعي.
وتتحدد سيطرة البنية الرأسمالية بوصول منتجي البضائع إلى سدة الحكم، وإزاحة ملاك الأرض وإقطاعيي السلطة السياسية، وسيادة العمل بالأجرة، وهي كلها أمور لم تتحقق في نهاية القرن التاسع عشر ولا في نهاية القرن العشرين العربيين !
ولكن مهدي عامل يُصادر ببساطة، قبل أن يبحث، فهو منذ البدء يقول  أزمة البرجوازيات العربية..) فأفترض إن هذه البرجوازيات قد حكمت وتعفنت في الحكم وهي مأزومة الآن ؟! في حين إن البناء الاقتصادي والسياسي لم تتحقق فيه شروط انتصار الرأسمالية !
أزمة البرجوازيات العربية..) فأفترض إن هذه البرجوازيات قد حكمت وتعفنت في الحكم وهي مأزومة الآن ؟! في حين إن البناء الاقتصادي والسياسي لم تتحقق فيه شروط انتصار الرأسمالية !
ولكن ذلك لا يتعلق فقط بالبحث الفكري بل والأخطر بالمهمات السياسية المباشرة، فيقول بأن:
( المهمة الأساسية لحركة تاريخنا المعاصر بهذا الشكل، لاتضح لنا أن تحققها يمر بالضرورة عبر عملية معقدة من الصراع الطبقي ضد البرجوازيات العربية المسيطرة ..)، ص 39.
ولكن كيف يمكن إسقاط أسلوب إنتاج لم يُسد وطبقات لا تحكم ؟
علينا أن نناقش مسألة أسلوب الإنتاج الكولونيالي التي طرحها مهدي عامل، كي نقوم بتفكيك تفكير هذا المفكر، وهي التي اعتبرها حجر الزاوية في نظريته حول تطور العالم العربي.
كما رأينا سابقاً، ( راجع الفقرة حول التاريخ العربي) إن مهدي عامل يرفض تحليل البنية الاجتماعية العربية الحالية من خلال جذورها، وهو ينتقد المفكرين العرب المجتمعين في الكويت لمناقشة ( أزمة تطور الحضارة العربية) بسبب قيامهم بالعودة إلى جذور التاريخ العربي، طالباً الوقوف عند العصر الراهن والنظر إلى الماضي من خلال البنية الاجتماعية الراهنة.
إن مهدي عامل ينظر للبُنى الاجتماعية العربية الراهنة وكأنها صياغة أوربية غربية، فقد قام الاستعمار الغربي برسملتها، أي بتحويلها إلى رأسمالية ناجزة، وهذه الرأسمالية الناجزة يُطلق عليها أسم (( أسلوب الإنتاج الكولونيالي ))، وبهذا قام مهدي بخطئين كبيرين مزدوجين، فهو قد قطع السيرورة التاريخية للبُنى العربية الاجتماعية، أي قام بإزالة طابعها الطبقي التاريخي، وهي عملية يقوم فيها بالتمرد على القوانين الموضوعية لرؤية المادية التاريخية عن التشكيلات الخمس: المشاعية، والعبودية، والإقطاع، والرأسمالية، والاشتراكية.
فهو عبر هذه المقولة قد ألغى كون البُنى الاجتماعية العربية بُنى إقطاعية، فحين لا نبحث ألف سنة من التطور الاقتصادي والاجتماعي السابق، ونعتقد أن أسلوباً جديداً للإنتاج قد تشكل، وأسمه الأسلوب الكولونيالي، في خلال بضع سنين، وأن علينا أن ننظر للتاريخ من خلال هذا الأسلوب غير المحدد والغامض، فتتشكل لدينا هنا رؤية سياسية دكتاتورية تحاول أن تفرض نفسها على جسد التاريخ الموضوعي، بمعطيات غير مدروسة.
إن رفض تحليل الماضي، أي بحث التاريخ الإقطاعي للعرب، يتضافر لدى مهدي عامل، ورفض تحليل الحاضر، أي قراءة عمليات التداخل بين الإقطاع والرأسمالية، كأسلوبين للإنتاج موضوعيين في التاريخ العربي الراهن، ويطالب بمناقشة أسلوب إنتاج من اصطلاحاته هو أسلوب الإنتاج الكولونيالي .
ومع هذا فعلينا أن نناقش تسمية أسلوب الإنتاج المقترح، فمهدي عامل لا يُنكر وجود بقايا نظام تقليدي في هذا الأسلوب الذي انتصرت فيه العلاقات الرأسمالية، ودون أن يطرح أية أرقام أو معطيات على انتصار العلاقات الرأسمالية الموهومة، لكنه يعتبر إن العلاقات الرأسمالية المنتصرة في العالم العربي تشكل علاقة تبعية مع العالم الغربي حيث العلاقات الرأسمالية الأقوى، وهذه الأخيرة الغربية هي التي تقوم داخلها بتقويض أساليب الإنتاج الأخرى، في حين تعجز الرأسمالية العربية في علاقتها التابعة من تقويض أساليب الإنتاج السابقة داخلها، وبهذا فإن أسلوب الإنتاج الكولونيالي الذي سادت فيه البرجوازيات العربية يحتاج إلى ثورات عمالية لتقويضه والانتقال إلى الاشتراكية.
تتشكل هذه العموميات الفكرية من منهج مجرد يفرض قوالبه على الواقع الحي غير المدروس، فتلغى مسألة التشكيلة الإقطاعية بجرة قلم، ويتم تحويلها إلى تشكيلة أخرى متطورة بقفزة خيالية أخرى هي التشكيلة الرأسمالية الكولونيالية، ثم تحدث القفزة الأكبر إلى الاشتراكية..ولا يزال الباحث لم يحلل الإقطاع العربي وسيرورته السابقة والراهنة.
والغريب إنه في كتابه هذا ( أزمة الحضارة العربية..) يناقش جملة من المفكرين العرب الذين يقدمون له مادة تحليلية ممتازة، ولو أنه أبعد فرضياته الإيديولوجية المسبقة، أو استفاد بعمق من الماركسية البنيوية التي نقل تطبيقاتها لفهم البنية الاجتماعية، لأمكنه أن يدخل إلى دائرة التاريخ العربي وتشكيلته التي تظرب أسماؤها لديه. ولكنه حدد منذ البدء هؤلاء الباحثين كمنظرين للبرجوازيات العربية المستولية على الحكم والتي وصلت إلى الأزمة، وبالتالي يجب نقد وعي هذه الطبقات المسيطرة عبر وعي الطبقات الثورية الخ..
حين يناقش مهدي عامل الباحث العربي الدكتور شاكر مصطفى يتجاهل مهدي المادة الفكرية الثمينة التي يقدمها شاكر لتوصيف تطور المجتمعات العربية بقوله:
( إن الاستمرار الاجتماعي الذي تعيشه الشعوب العربية إنما تحكمه عناصر عديدة في مجموعها التركيب العربي القائم.. وأن لامتدادات التاريخ في هذه العناصر المكان الواسع إن لم يكن الأول..) وهذه ( العناصر الأساسية الباقية عند أربعة جوانب:
أ ــ طرق الإنتاج المادي ب ــ تكوين نظام السلطة ج ــ طبيعة العلاقات الاجتماعية د ــ قيم الفكر التراثية ..)، ص 43.
هكذا نرى لدى شاكر مصطفى نظرة تاريخية موضوعية واقتراباً دقيقاً من فهم أسلوب الإنتاج الإقطاعي العربي الإسلامي المستمر عبر ألف سنة، الذي يتأسس في نظام السلطة والإنتاج معاً، ثم يتمظهر في العلاقات الاجتماعية: الأبوية، هيمنة الذكور ، اللامساوة الجنسية، الطائفية الخ..ثم يصل النظام الإقطاعي إلى المستوى الثقافي: الأمية، الخرافة الخ..
إن شاكر مصطفى يمثـل مقاربة علمية ( ماركسية ) من فهم التاريخ، ولكن ماذا يفعل مهدي عامل بمثـل هذه المقاربة ؟
بدلاً من أن يقوم بفهمها ودرس التاريخ العربي يقوم بالمصادرة السريعة، فيقول:
(أما أن يكون هذا التاريخ الذي تكونت فيه البنية الاجتماعية للواقع العربي الحاضر، تاريخاً يرجع إلى ما قبل عشرة قرون خلت، أي إلى العصر العباسي أو أواخر العصر الأموي، فهذا ما نختلف فيه جذرياً مع الدكتور مصطفى )، ص 45.
فهو يحتار كيف أن هذه البنية المزدهرة يوماً ما تصبح هي نفسها سبب التخلف ؟ فيقول بلغته المعقدة الغامضة:
(فالبنية هذه ليست في حاضرها، من حيث هي بنية، أي كلٌ معقد متماسك، سوى البذرة التي كانتها في الماضي، تنامت ، فتنافت وتواصلت في حركة من تماثـل الذات بالذات، وما الذات هذه إلا الذات العربية نفسها.)، ص 45.
إن مهدي عامل الذي ينتقد شاكر مصطفى على أنه صار يفكر بمنهج هيجل الجدلي المثالي، يعجز عن اكتشاف رؤية الوعي الموضوعي لدى مصطفى شاكر في فهمه للتاريخ العربي، ويصبح هو هيجلياً مثالياً.
فالبنية العربية الإقطاعية زمن الإمبراطورية العباسية كانت نظاماً مركزياً، والإقطاع المتحكم في الخراج الهائل يصرفه على البناء الترفي والثقافة المقربة المفيدة للنظام، ثم يتحلل هذا الإقطاع المركزي بسبب ثورات الشعوب، ليجيء نظام الإقطاع اللامركزي، وتظهر الدول والدويلات الإقطاعية، وتكرر بشكل أوسع إنجازات ومشكلات النظام السابق، ثم يتهرأ هذا النظام الإقطاعي الديني العام بتشكيلاته المتعددة، ليغدو أنظمة وإمارات إقطاعية صغيرة مذهبية الخ..
إن هذه السيرورة التاريخية تحافظ على قسمات عامة أشار لبعضها شاكر مصطفى في المقطع السابق ذكره، حيث يغدو الحكام هم المستولون على القسم الأكبر من الثروة العامة، وتتواشج السلطة والثروة، ويشركون رجال الدين في السيطرة على العلاقات الاجتماعية، أي ينقلون العلاقات الإقطاعية إلى البيوت والأحوال الشخصية الخ..
وإذا لم نقم كما يريد مهدي عامل بقراءة هذه السيرورة التاريخية الاجتماعية التي امتدت خلال ألف سنة، والتي تتغلغل في أبنيتنا الاجتماعية وقوانينا الوراثية وفي سلطاتنا المطلقة، وفي شعرنا ونثرنا وعاداتنا ولاوعينا، فكيف نقوم بتغيير هذه البنية التقليدية وتشكيل النهضة ؟!
إن مهدي عامل يخرق قوانين الوعي على مستوى قراءة الماضي، وعلى مستوى قراءة الماركسية، فعبر قراءة الماضي يتجاهل البنية الإقطاعية وسيرورتها الراهنة، وعلى مستوى الماركسية يقوم باختراع مغامرات سياسية محفوفة بالكوارث، عبر اختراعه مقولة أسلوب الإنتاج الكولونيالي وتصفية البرجوازيات العربية.
فهو بدلاً من قراءة الماضي ورؤية أسباب عجز البرجوازيات العربية القديمة عن تشكيل النهضة، والقيام بثورة رأسمالية، وقراءة أسباب ضعف البرجوازيات العربية الراهنة وعدم قدرتها على تغيير أسلوب الإنتاج الإقطاعي وتشكيل تحالف معها لتغيير التركيبة التقليدية يقوم بوضعها في خانة العدو والقفز ضدها إلى مهمات غير حقيقية ومكلفة كما دلت تجربة الشعب اللبناني.
يمثـل المفكرون الذين تواجدوا في الكويت لمناقشة مسائل النهضة العربية وكيفية إيجادها، نخبة اشتغلت في حقول الدراسات لزمن طويل، وبغض النظر عن اجتهاداتها ومدارسها فإنها تعبر عن عقول مهمة تعارض المجتمعات العربية التقليدية من منطلقات مختلفة، لكن المفكر اللبناني مهدي عامل نظر إليها كخصوم وليس كقوى مساندة للطبقات العاملة العربية في تغيير مجتمعات التخلف، وبهذا كان يرفض العديد من الآراء المهمة التي تقدمها كما فعل مع مصطفى شاكر.
ويعترض مهدي عامل كذلك على زكي نجيب محمود الذي يمثل المدرسة الوضعية أو التجريبية المنطقية في دعوته لأحكام العقل في النظر إلى الأشياء، وخاصة في جملته التي قالها بضرورة (الاحتكام إلى العقل في قبول ما يقبله الناس وفي رفض ما يرفضونه)، ودعا الدكتور زكي العرب إلى التوجه لتمثل الحضارة المتقدمة، واعتبر إن الاحتكام إلى العقل ميز الحضارات العقلانية، معطياً نماذج أربعة على حضارات احتكمت إلى العقل وهي:
أثينا في القرن الخامس قبل الميلاد، وبغداد في عصر المأمون، وفلورنسة في القرن الخامس عشر، وباريس في عصر التنوير في القرن الثامن عشر.
أي إن زكي نجيب يقدم درجات من صعود البرجوازية عبر العصور، أعطى إنتاجها المادي قدرة على الفهم الموضوعي للطبيعة المجتمع، على درجات متفاوتة.
ويعترض مهدي عامل على هذه التصنيفات ويقول:
(وهنا تظهر الدلالة الطبقية لهذا المنطق من التفكير: فانتفاء الطابع التاريخي، أي النسبي، من شكل العقلانية الخاص بالبنية الاجتماعية الرأسمالية يجعل من هذا الشكل الخاص مطلقاً، فيظهر ما هو تاريخي ــ أي ما يحمل فيه ضرورة تخطيه ونفيه ــ بمظهر ما هو طبيعي ــ أي يحمل فيه ضرورة تأبده ــ ويظهر الشكل الطبقي البرجوازي للعقلانية بمظهر العقلانية الإنسانية، أي بما هو طبيعي ملازم للحضارة كحضارة ..)، ص 34.
يتحول تقديم زكي نجيب محمود لصور من العقلانية عبر التاريخ في وعي مهدي عامل إلى وجهة نظر ل ( البرجوازية المسيطرة )، هكذا بشكل مطلق وكأن زكي نجيب محمود يمثل برجوازية مسيطرة تقوم بإخفاء التناقضات الاجتماعية المحتدمة تحت سيطرتها مثلما تفعل البرجوازية الفرنسية التي درس في عالمها مهدي عامل ونقل لغة النقد الموضوعي ضدها، وليس باعتبار زكي مفكراً يعبر عن فئات برجوازية عربية تعاني من هيمنة تقليدية متخلفة، وحين يقوم باستعادة لحظات من فعل الفئات المتوسطة عبر التاريخ الماضي إنما يريد شحذ عقلها وإرادتها من أجل تشكيل عالم نهضوي عقلاني عربي، يمكن حتى للقوى الشعبية فيه أن تناضل بصورة حديثة.
إن المحطات التي اختارها زكي نجيب محمود للحظات التاريخية التي بدأ فيها أسلوب الإنتاج الرأسمالي بالصعود هي محطات تـُظهر هذا الأسلوب الجديد في تشكيلات متنوعة، بدءً من التشكيلة العبودية لدى الإغريق، أو التشكيلة الإقطاعية عند العرب، أو بداية انحسار الإقطاع لدى التجار الإيطاليين في فلورنسة، ثم انتصار الأسلوب في الثورة الفرنسية.
وفي هذه المحطات حاول العقل الممثل للفئات الوسطى أن يحرر النظام الاجتماعي من هيمنة الخرافة وتدخلها ومنعها لاكتشاف السببيات المعيقة للتقدم ونمو العلوم والتجارة الخ..ولكن في الثورة الفرنسية لم تعد ثمة فئات وسطى بل طبقة برجوازية صناعية قائدة منتصرة تعيد تشكيل البنية الإقطاعية.
وبطبيعة الحال فحين يُقال هذا الكلام للجمهور العامل الفرنسي الآن، يغدو هذا مجرد كلام تاريخي، فالبرجوازية الفرنسية الراهنة هي غير برجوازية الثورة، ولكن حين يقول هذا الكلام زكي نجيب محمود في العالم العربي الإقطاعي الطائفي المتخلف، يغدو الأمر ثورياً.
ويجري العكس لدى مهدي عامل الذي ينقل الوعي المعارض الفرنسي في الرأسمالية الكلاسيكية، أي في الرأسمالية التي غدت عائقاً للإنتاج، إلى البلدان الجائعة للتطور الرأسمالي الصناعي خاصة، وبدلاً من أن يبحث كيفية نموها وتغييرها للإقطاع، مثمناً البذور النقدية الوضعية والتجريبية، لزكي نجيب محمود ومعاضداً إياه لتوسيع الجبهة المعادية للتخلف والإقطاع، يطالب بإسقاط مثل هذه البذور والمقدمات للتحول الحديث، قافزاً إلى مهمات غير ممكنة.
وهكذا فحين يُظهر زكي نجيب محمود العقلانية البرجوازية كما يقول مهدي عامل كعقلانية مطلقة، كعقلانية تمثل البشر جميعاً، كعقلانية وحيدة، فهذا نتاج لوعي مثالي يُغيّب شروط الثورة الديمقراطية في البلدان المتخلفة، معتبراً العقل شيئاً تجريدياً، وليس مصانع يجب أن تتوسع، ومختبرات علمية يجب أن تنتشر، وعمالة جاهلة يجب أن تتعلم وتتحسن معيشتها، وريف إقطاعي يجب أن يتحدث، ونساء ينبغي أن يدخلن مجال الآلة الصناعية الخ..
رأينا في بعض الأمثلة التي سقناها من حوار المفكر اللبناني الراحل مهدي عامل مع شخصيتين ثقافيتين عربيتين كبيرتين، المستوى العام، السياسي، الذي يتصدى فيه المفكر اللبناني لوجهات نظر من الفئات الوسطى العربية، وهي تحاول أن تطرح وجهات نظر لتجاوز عالم التخلف والإقطاع العربي.
والمقصود بالمستوى العام السياسي، إن مناقشة كتابه ( أزمة الحضارة العربية أم أزمة البرجوازيات العربية ؟) من قبلنا في هذه الموضوعات، تعلقت بمعرفة رأيه في مسألة التشكيلة الاقتصادية / الاجتماعية السائدة عربياً، وهي مسألة قام مهدي عامل بتضبيبها بشكل شديد، من جهة تمييع حدودها بما يتعلق بالماضي، فيتم قطع العلاقة بتحليل الماضي من حيث إنه سيرورة تاريخية مستمرة إلى عصرنا العربي الراهن، أي بسبب استمرار التشكيلة الإقطاعية الدينية إلى وقتنا الراهن، وهي تحاول إفراغ التشكيلة الرأسمالية الجديدة التي لم تنتشر انتشاراً واسعاً، من مضمونها، ولعدم انتصارها.
ومن هنا لا يقوم مهدي عامل بدراسة هذه التشكيلة الماضوية الحاضرة في تطورها وفي اعتقالها للتطور العربي، ويغدو الاقتراح النظري باسم ( أسلوب الإنتاج الكولونيالي ) شكلاً من التمويه الفكري والسياسي لعدم حل مشكلات البنية الإقطاعية السياسية الدينية، باعتبارها العائق الأكبر في سيرورة التطور العربي الراهنة، قافزاً إلى مهمات تعود إلى بُنى الرأسمالية المعاصرة الغربية، وهذا في التطبيق العملي السياسي يقود إلى انتصار الإقطاع السياسي والديني، عبر توجيه العداء والضربات إلى حليف سياسي واجتماعي وفكري للقوى الشعبية، هو قسم من الفئات الوسطى الحديثة ومثـقفيها، خاصة للتيارات البرجوازية العلمانية والديمقراطية.
إن مهدي عامل في رفضه لاستمرارية التشكيلة الإقطاعية، وإحلاله التشكيلة الرأسمالية، حتى مسمى علاقات الإنتاج الكلونيالية، رفض الأساس الموضوعي لفهم التطور العربي، ومن هنا يغدو المفكرون الذي يفند آراءهم في الكتاب المذكور، أكثر اقتراباً من الحقيقة الموضوعية، ومن المهمات السياسية والاجتماعية والثقافية، من مهمات التغيير العربية الحقيقية، رغم مناهجهم التي تعود لاختيارات أيديولوجية للفئات الوسطى، أكثر من قراءته التي يقوم فيها باستيراد أدوات فكرية منهجية غربية ماركسية مهمة، لكنه لا يطبقها التطبيق الصحيح.
ليس ذلك كذلك إلا بسبب مقاربتهما ( والمثالان هما شاكر مصطفى وزكي نجيب محمود ) للتشكيلة الاقتصادية / الاجتماعية الإقطاعية الدينية، بمستويات معينة من القرب والتحليل، وهو بدلاً من مقاربتهما وتطوير أدواتهما ووعيهما، قام برفض كلي لتلك المقاربة النقدية للتشكيلة المحافظة.
إن المشكلة المزدوجة هنا هي في وجود أداة فكرية تحليلية صحيحة لدى مهدي عامل رُكبت في منظومة سياسية خاطئة، بمعنى أنه قرأ البنيوية الماركسية لدى جولدمان وآلتوسير واستوعبها، غير أنه حينما جاء إلى تشكيلته السياسية الحزبية العربية التي تطرح تجاوز البرجوازية وهدم سلطتها، ركب أداة نظرية حديثة دقيقة، في رؤية (ماركسية لينينية ستالينية) متخلفة.
وفي الموضوعات السابقة رأينا القضايا التي تقارب مسائل التشكيلة، وهي المسائل السياسية العامة، والتي هي العمود الفقري لمسائل الوعي والفكر والثقافة، وبدون الحل الصحيح لهذه المسألة المحورية فإن القراءة الفكرية كلها تكون محفوفة بالأخطاء، ولهذا تكون لنا عودة أخرى مع مهدي عامل ومناقشاته لمفكرين عرب تجمعوا في المكان والعصر العربي الراهن للعمل من أجل النهضة.
عبـــــــدالله خلــــــــيفة : في الأزمة الفكرية التقدمية
لم يتابع نشطاء جبهة التحرير الوطني البحرانية وكذلك مناضلو الجبهة الشعبية عمليات التخلخل العميقة فى المعسكر الاشتراكي بصورة علمية، فهم انتقلوا من تأييد عمليات الإصلاحات التي قام بها جورباتشوف في الاتحاد السوفيتي التي لم تكن أبعادها مفهومة حتى لجورباتشوف نفسه، إلى رفضها المطلق حين تبينت أبعادها التفكيكية لجسم الاتحاد السوفيتي، باعتبار جورباتشوف عميلاً غربياً، وقد طفحت مثل هذه (الأفكار) على ألسنه القيادات وبعض القواعد، وهى كلها مذهولة كبقية أفراد البشر في الكرة الأرضية، من هذا الانهيار. لم يحدث أي تحليل موسع، أو قراءات فكرية عميقة لعمليات التغييرات الكبرى هذه، ليس فقط لطابع كوادر الجبهتين اللتين اتصف عملهما بالتركيزعلى الشعارات السياسية الرائجة، بل لأن نشاطهما في تلك السنوات الانفجارية الروسية، قد وصل إلى الإنهاك السياسي الكبير، بعد تضحيات جسام في السجون والنشاط السري والمنافي منذ الخمسينيات، وما عاد في قدرة القيادات سوى المساهمة في أي نشاط يطفح على السطح. وكان انهيار الاتحاد السوفيتي يترافق مع نمو الحركات المذهبية السياسية في البحرين والعالم الإسلامي عموماً، وكان المظهران المتناقضان في الواقع يعبران عن جوهر واحد، هو نهوض الأمم الشرقية في عالم الصراع الكبير مع مركز السيطرة على الكرة الأرضية المتمثل في الغرب الرأسمالي. فالأمة الروسية في الواقع كانت تقوم عبر جورباتشوف بهدم (رأسمالية الدولة الشمولية) أو الرأسمالية الحكومية المركزية، والتي اتخذت في عيون الشيوعيين العرب مظهر النموذج الوحيد للاشتراكية، وهذا النموذج يصل في وعيهم أو لا وعيهم بدرجة خاصة، إلى المثال الديني المقدسي، فرفضه أو التشكيك فيه يصل إلى درجة الخيانة، أو الكفر، لأن عالم منظوماتهم الفكرية، يقوم على مجموعة مقدسات، هي فكر لينين الطاهر المقدس، والاتحاد السوفيتى المزار، أو الصين في رواية أخرى، ورمز الجنة الأرضية. والأب الحاني و الشقيق الأكبر.
لكن طبقات الأمة الروسية كانت قد وصلت إلى مرحلة استنزاف بسبب النظام البيروقراطي الحكومي، الذي قام بتحولات هائلة ولكنه وصل إلى الأزمة العميقة. وظهرت برجوازيات حكومية استنزفت الموارد وأوصلت نفسها إلى سدة الحكم مبعدة العمال من مركز الاهتمام الاجتماعي.
كان هذا يعني على المستوى العالمي (أزمة الماركسية – اللينينية)، فهذا الفكر تصور قدرته على نقل روسيا والبشرية كلها إلى الاشتراكية الخالية من الطبقات وذات القدرة الهائلة على الثورة العلمية والتقنية، لكن في عمق التجربة الروسية الفكرية كان هناك حدسٌ بأن هذا الفكر هو واجهة للقومية الروسية في عملية ثورتها القومية النهضوية، وإن ما كان انجازاً ودوراً عالمياً تحريرياً، بدأ يتحول إلى عبء، فروسيا التي ساعدت شعوب آسيا على الانتقال من العبودية والإقطاع إلى النهضة الحديثة، وفرت لها رافعة جاهزة لعملية نقل القرى وعالم العبيد والأمية والحرف إلى عالم الصناعات الكبرى والكهربة والتعليم الشامل الخ.. إضافةٍ إلى المساعدات الهائلة لدول المعسكر (الاشتراكي) ولحركات التحرر الوطني..
إن عمليات تفكيك الاتحاد السوفيتي وسحب روسيا من المنظومة الثورية العالمية، وعدم الصرف على خمول المعسكر الاشتراكي، قراراتٌ جذرية اتخذتها قوى الرأسمالية البيروقراطية والأجهزة العسكرية والاستخباراتية الروسية، فيما وراء ظهر جورباتشوف ومجموعته، التي تصورت أن ثمة إمكانية لعملية انتقال من المجتمع الاشتراكي الاستبدادي إلى المجتمع الاشتراكي الديمقراطي. وهذا التوصيف الحالم من قبل جورباتشوف، ينقصه عدم فهم طبيعة النظام الرأسمالي الحكومي الذي كان يتربع على قمته، بمعنى أن فهمه للماركسية لم يكن ماركسياً، وبمعنى آخر أيضاً بأن (الماركسية – اللينينية) كانت وعياً قومياً رأسمالياً روسياً تشكلَّ بأدوات السيطرة الحكومية الشمولية. وكان إدخال الانتخابات وأدوات العمل الديمقراطي على هذا الكيان يعني وصول هذه البرجوازيات البيروقراطية في كل بلد من بلدان الاتحاد السوفيتي إلى السلطة، وبالتالي هدم الاتحاد السوفيتي الذي أقيم على تحالف مفترض وهمي بين العمال والفلاحين، أي أن هذه الطبقات المنتجة ابعدت عن السلطة خلال عقود الدكتاتورية الفردية السابقة، وهي التى قامت عبر تضحيات عملها وثماره بتصعيد تلك السلطات البيروقراطية وخلق منجزات التحديث الهائلة، وبالتالي فإن هذه الجماهير راحت فكرتها الاشتراكية التضحوية تتحطم سياسياً فتعود لما قبل الماركسية اللينينية، أي للدين والوعي القومي وهما الشكلان من الوعي المنتشران والسائدان المتواريان.
لم تفهم أممُ آسيا خاصة في روسيا والصين وفيتنام أن تحولاتها تجري نحو الرأسمالية الحديثة، وقد وجدت في (الماركسية ـ اللينينية) ضالتها للحفاظ على هويتها القومية المتوارية وعلى جهاز الحكم المركزي القائد والمسيطر عبر التاريخ.
ولكن تطور القوى المنتجة بعد إنشاء الصناعات الثقيلة واجه صعوبات هائلة من ذلك الجهاز الحكومي الذي كان قائداً وحيداً في التنمية، فاستدعت الضرورات تفكيكه ونشر الصناعات الخاصة ولتطوير قوى الإنتاج المتخلفة عن مستوى الغرب واليابان في حمى تطور الأسواق والاستيلاء عليها.
إن الأحزاب الشيوعية والمنظمات التقدمية العربية لم تفهم طبيعة التحولات هذه، وكان لايزال الشكل النضالي المساواتي التقشفي البروليتاري مهيمناً على الوعي العام، في حين تم نخره من قبل التطلعات البرجوازية الداخلية، التي راحت تتغلغلُ في القيادات والأعضاء. وكما حدث في القيادة السوفيتية ذلك التناقض بين مُثل الاشتراكية القديمة المسحوقة، بين الأنانية القيادية وانتفاخ الزعامات المغرورة بدورها، وبين الانضباط والطاعة الثورية لدى القواعد المتردية أحوالها، كما حدث ذلك في الاتحاد السوفيتي وخرّب التجربة النضالية الوطنية الشعبية، فقد حدث ذلك في الأحزاب الشيوعية والتجمعات التقدمية العربية المختلفة.
فالكلام عن المبادئ والقيم النضالية والتضحية تم خرقه ببيروقراطية الإدارات وانانيتها السياسية والاجتماعية، فالتضحية تكون من نصيب القواعد والمكاسب تكون لجانب القيادات. السجون والتعذيب والبطالة والفقر تكون من نصيب الأعضاء البسطاء، وعضوية القيادة الخالدة والكراسي البرلمانية والبيوت والسفرات والثروة تكون من نصيب القيادات.
ولكن إذا كان هذا التناقض الاجتماعي قد حز في التكوين السياسي وعد قوى العمال والفلاحين عن هذه الأجسام، فإن هشاشة التكوين الفكري الذي تجسد في القبول السطحي بـ(الماركسية – اللينينية) كان هو العامل الأكبر في الأزمة الفكرية. فكأن العقل (التقدمي) يستوردُ الموادَ الفكرية وينقلها في جسمه السياسي، ويغدو موقفه الوطني هو تعليق سياسي مُبسّط عما يدور في بلده. إن عدم قدرته على التحليل هو وليد هذه العقلية الاستيرادية، وتتحول هذه المواد إلى مواد مقدسة، يسود فيها الحفظ والترتيل الديني، وتشع حولها الطهارة، ثم تنقلب مع اكتشاف الفساد في مراكز القيادة، أو اكتشاف الضعف والتخلف عن التطور فيها، إلى صدمة روحية.
إن الإيمان العاطفي المطلق ينقلب إلى كفر كعادة الوعي الديني، وانتقاله بين المتضادات التي يعجز عن القيام بالتركيب فيها، فيجري التنصل من الأفكار أو الارتدد إلى الشائع والشائع دائماًهو الوعي الديني والوعي القومي. وهما الشكلان الأساسيان من الوعي في نمو الأمم في مراحل الإقطاع والرأسمالية. وبهذا فإن الوعي التقدمي الذي كان يجزم بوجود الاشتراكية يتخلى كلياً عنها. فيهتف بأن لا وجود سوى للرأسمالية والمصالح الخاصة!
أو أن بعض قطاعاته ترى الرأسمالية كخيار أفضل من التجمعات الدينية المحافظة التي تمثل خطراً على النهضة، أو أن الزعيم المغمور يتمرد على الزعيم الرسمي الخ.. في حين تتوجه القواعد الشعبية التي لا تزال تهجسُ بمُثل المساواة إلى البقاء في الكليشيهات القديمة، فتظهر أمثولة المهدي هنا بأن لينين عائد، وإنه حي، ويعود بعضها للعبادات الدينية كليةٍ متصوراً بطرق تفكيره الشكلية أن هذا هو الإسلام. ويحافظ بعضها كلية على الماركسية اللينينية بشكلها النصوصي القديم ويزاوجها أحياناً مع ابتهالات دينية ما لتأكيد طابعه المحلي. والبعض النادر يواصل الحفر والاكتشاف بأن الدول (الاشتراكية) نمط خاص من الرأسماليات الدول في العالم المتخلف، وإن الماركسية منهج في البحث ونظرة كونية ويجب إبعادها عن التطابق مع تجربة البلدان الشرقية التنموية السياسية الخاصة المرحلية.
وفي حين أن منتجي هذا الوعي الأخير قليلين بين التقدميين يكثر منتجو أشكال الوعي الأخرى، ولذلك أسباب عميقة داخل أبنية الجماعات التقدمية المختلفة.
إن الخيط النضالي الديمقراطي الشعبي لا ينقطع في الأجسام التقدمية العربية مهما كان هذا الخيط واهياً في المراحل الانعطافية الصعبة، فهو وليد تضحيات جسام، والدوائر الشعبية المختلفة تراها تحافظ على هذا الخيط حتى وهي تختلف عنه، داخل ممارساتها الدينية، بسبب حدسها الطبقي، فضياع تنظيم تقدمي هو فائدة كبيرة لقوى الاستغلال التي «تدهس» أجورَها وأحلامها الاجتماعية.
لكن قوى الاستغلال الشمولية تعمل بقوة على شطب هذا الخيط من التاريخ، أو على الأقل الاحتفاظ به كتحفة فنية. فالمساهمة في فصل القيادة عن القواعد، وحفر الانقسام المذهبي، وتفتيت الأجسام السياسية الخ.. هي من أدوات الرأسمالية الحكومية العربية في تكريس دورها المطلق في الاقتصاد ونهب فوائضه.
أما القوى الدينية المختلفة ففي أقصى تجربة لها هي تعمل على رأسمالية حكومية مركزية مسيطرة على الجمهور، لتقوم بالدور نفسه ولكن مع أحجبة إسلامية ولحى طويلة.
لكن التقدميين وحدهم قادرون الآن على فهم تجربة رأسمالية الدولة وتعزيزها ونقدها وتطويرها، كشكل من الثورة الاقتصادية المركزية المساندة بقطاع خاص مستقل وبعالم من التعددية السياسية، وهو أمر يحدد طبيعة التحالف بين التقدميين والليبراليين والدينيين المنتقلين للديمقراطية.
لكن هذه البلورة السياسية للنظام المراد تشكيله تصطدم بتلك الفسيفسائية التقدمية، التي دمرت أخطاءها الفكرية، بسبب عدم فهمها تجربة سياسية، هي تجربة الدول «الاشتراكية». فهي تخلت عن المادية الجدلية والمادية التاريخية في سبيل دكتاتورية البروليتاريا، وكأن الفكر المادي الجدلي لا يقوم إلا على الدكتاتورية الاجتماعية! في حين أن الفكر ذاته وُجد في الغرب وتطور في الغرب من دون الحاجة إلى تلك الدكتاتورية.
إن الشرقيين الشموليين يعكسون ميراثهم الديني والاجتماعي على النظريات العلمية، لكن الآن تتطلب دقة المواقف وتركيبها استخدام المناهج وتحليل الحياة بها، فيتطلب الموقف إنتاجاً وليس نقلاً.
إن الماركسية الاستيرادية السابقة تعجز عن القيام بتحليلات مُعمقة للبناء الاجتماعي في كل بلد عربي، ولهذا فإن المواقف التقدمية تقوم بالعودة إلى تراث المنطقة والتغلغل فيه، فتصبح هذه المواقف التقدمية عربية وإسلامية ومسيحية وعائدة كذلك للتراث الحضاري القديم، لا بمعنى تشرب طرق تفكيرها الغيبية ومنظومات عباداتها، بل رؤية دورها الاجتماعي النضالي كخلفية مهمة للفكر التقدمي العربي المعاصر وكجذور متميزة للمنطقة، وهي عمليات تحتاج إلى تزاوج بين البحوث العلمية والعمليات النضالية اليومية.
ولهذا فإن التقدميين قادرون على الغوص في تراث كل طائفة دينية، ورؤية العناصر الكفاحية فيه، ودراسة مُثُل هذا التراث، وإبعاد المنتمين إليه عن التحجر في أشكاله المتيبسة وعن التعصب، وتوعيتهم بالأبعاد المغيبة العظيمة في هذا التراث، وتطويرهم وتوحيدهم لمهمات الأمة والشعب والإنسانية.
إن هذه المستويات المركبة من التفكير والسلوك، تتطلب أعضاء على مستوى كبير من العمق الفكري والمسئولية السياسية والنشاط، ولكن حين تتحول التنظيمات التقدمية إلى كم تحصيلي من الأعضاء السابقين من المراحل السابقة (يعكس الانهيار أكثر من المقاومة)، تفقد قدرتها على التحول إلى أداة قادرة على فعل شيء مميز في هذه المرحلة المعقدة.
والأزمة التنظيمية هي تعبيرٌ مركب كذلك عن مجمل الأزمات وخاصة الأزمة الفكرية، فالأزمة الفكرية هي نتاج كل التحليلات السابقة، وهي تؤدي إلى الشلل السياسي الذي يهدم كل فكر.
في عودة التقدميين البحرينيين من الخارج تولد انحرافان؛ انحراف نحو اليمين يضع أغلب الأوراق في يد الإقطاع السياسي، وانحراف يساري يضع أغلب الأوراق في يد الإقطاع الديني.
وحين ينفي الخارجُ التقدمي المسيطر الداخلَ التقدمي نلمحُ ثنائية القاعدة البيروقراطية التي شحبت قدراتها على التحليل والممارسة، ولكنها تفرض منظومتها على القواعد المضحية للحصول على مكاسب شخصية.
لكن هذا يتبدى بشكلين إيديولوجيين خادعين، أي عبر انحرافين متضادين في الشكل متحدين في الجوهر، فالأول يركز على مماشاة (الإصلاح) وعدم نقده وتحليله، وبالتالي مسايرة خطواته من دون وجهة نظر نقدية، والثاني يرفضه ويعتبره خدعةٍ ويواصل مماشاة القوى المذهبية التقليدية القائدة للنزاع المذهبي. أي أن الاثنين يتوخيان الدعم عبر قوى الإقطاع أو التقليديين.
إن الموالاة والمعارضة إذن ليستا لتكوين تيار تقدمي مستقل بل لوصول أقطاب التقدميين المعارضين القادمين من الخارج إلى مناصب وامتيازات ثم إلى كراسي البرلمان أن استمر تدعيمهما بالانتخاب أو التعيين.
ولم تفعل قواعد التقدميين أي شيء جدي وكبير لوقف هذه المأساة، فنظراً للتكتيكات المتبعة في غمر الجمعيات بكل لون، وتذويب العناصر المضحية في شوربة سياسية، أمكن للبيروقراطية المسيطرة أن تشتت العناصر المناضلة وأن تضيع جهودها، وتمزق القواعد التقدمية التي جرى العسف عليها واضطهادها وتشتيتها خلال عقود.
وبهذا فإن إمكانية إنتاج فكر تقدمي مستقل عبر هذا الاضطهاد المزدوج تغدو مسألة غير ممكنة.
إن تراث نصف قرن ضاع في بضع شهور. فعاد التيار المهلهل من التقدميين بمختلف تجلياتهم إلى إرث الإقطاع.
إن مسألة الأوضاع السياسية تبقى مسألة رؤوس فردية من الذكور المتناطحين، فهذه الرؤوس هي التي تسود ..
لقد ضاع تراث التقدميين البحرينيين على مستوى تجميع المادة السابقة وعلى مستوى درسها وقراءتها بموضوعية هذا الزمان وليس بخطابية وعاطفية ذلك الزمان.
وعوضاً عن إنتاج وعي وطني ديمقراطي جماهيري تخشب اليسار في أطروحاته القديمة، وحين جاء خلال هذه السنين سيطر عليه الانحرافان السابقان ومنعاه من إنتاج مثل هذا الوعي الوطني الديمقراطي التوحيدي.
في الانتخابات القادمة ونتائجها ستغوص البلدُ أكثر في الأزمة التي ستغدو شاملة، وستقوم القوى المذهبية السياسية بتفكيك البلد في مختلف طوابق بنائه الاجتماعي.
إن التغييرات السياسية تتطلب تغيرات عميقة في الهيكل الاقتصادي، ومع بقاء هذه المشكلات العميقة في الحياة الاقتصادية وعدم حلها بل تفاقمها، فإن أدوات الحل السياسية المغلوطة في (الإصلاح)، ستفاقم تلك المشكلات وتحولها إلى أزمة عامة بدلاً من أن تقوم بحلها.
وقد كان التقدميون هم أساس الحل ولكنهم تحولوا إلى جزء من المشكلة وساهموا في تعميق الأزمة.
إن مسئولية القواعد التقدمية كبيرة في هذه الفترة وستوضح لهم الفترة القادمة أهمية وحدتهم وتنظيف صفوفهم من الانحرافات والبدء بشكل نقدي جديد.

September 11, 2022
إنساننا البسيط المتواضع : عبـــــــدالله خلــــــــيفة
 #عبدالله_خليفة..
#عبدالله_خليفة..إنساننا البسيط المتواضع
حين نطالع البنايات العمالقة التي تلامسُ أحياءَنا البسيطة في القضيبية والحورة وراس رمان والغريفة، حين نرى إتساعَ البحر، وإنفساحَ المجال والأفق للجزرِ البعيدة، نقول لماذا نختنقُ في هذه البقعة الصغيرة وكأننا محشورون حشراً؟
إن العمال الأجانب بشر ليسوا من فلين وقشور سمك، أناس عبروا محيطات وإنحشروا في الأزقة والبيوت الكبيرة القديمة والشقق الصغيرة، وكأن المدينة الكبيرة لم تعد سوى أحياء متلاصقة متزاحمة وسوق عارم.
ملايين تأتي وتخرج من هذه البقعة الصغيرة، يقتحمون الأزقة والأعمال، يقطفون بعض رزق الناس، يرتفعون في المعيشة، يكبرون، يُسيّرون أحدث موديلات السيارات!
لكن لم يقم أحدٌ من المواطنين بتكسير مصباح أو خدش إنسان بسبب هذا!
شعبٌ يعيش ببساطته وفقره وبعض غناه لكن لم يقبض على رقاب البشر!
تعلم الحضارة بسرعة، أسألْ الشركات الأولى التي جاءتْ لتحفرَ الآبار في الصحارى حيث لا ينابيع وبيوت!
أسألْ قيعانَ البحار التي غاصَ فيها بحارة صاروا عمالاً ولحامين.
تجاوز العمالُ والأجانب مقادير أعدادنا، والأقتصادُ المتطورُ يحتاجُ كتلاً هائلة، وإختصاصات، نعرف ذلك ونحن نتعلم وسنتعلم، لنتحكم في الأجهزة المعقدة والمواليد والإختصاصات والمهن والعلوم، لنكون بديلاً عن بعضهم أو كلهم.
نرحبُ بهم بشرياً بشكل متناقض إنسانياً، لا نقول إننا ملائكة، نستغلهم نرثى لهم، نصاب بالضيق منهم لكن لا تمتد أيدينا إليهم!
نحن بلاد صغيرة تطلق فيها الوزارات كل العربات والسيارات والسياح والمرور والتجار والعابرون . . لديها على الأوراق أرقام، لا تعرف أنها أشياء وكائنات ودخان وزحام وأمراض وجراثيم تتنتقل عبر البلدان والقارات!
لديهم أوراق ويفرحون بإنجازنا: إننا الدولة الخامسة والعشرون في الحريات الاقتصادية؟
نريدها أن تكون الثلاثين في إهتمامها بعيش المواطن وصحته وعيشه وتقدمه وسيطرته على دخل بلده!
حين إنتفضتْ البلدُ كلها من أجل الصياد البحار المضروب بالرصاص عند أسيجة مجلس التعاون العربي الخليجي أدركنا إننا شعب واحد؟!
إنتفضتْ قلوبنُا بعمق وأسى، توحدنا.
البحرينيون أعطوا الخليجَ العلمَ والنور والمدرسين والباحثين والكتاب الذين يشتغلون في الجرائد والمراكز العلمية والثقافية..
أشعلوا النيران في رأس تنورة ليتدفق النفط!
إشتغلوا في حفر الآبار في الصحارى وجزر الخليج الفارغة من البشر..
غنوا وصنعوا مع من صنع في الخليج الأغاني الأولى.
تعلموا الآداب والفنون فشاركوا ريادة صنع الصحافة والثقافة، ووزعوا أنوارها على المنطقة.
تعلموا قبل الآخرين وإستقبلوا أخوانهم على مر السنين، عملوا بجد وتعب، إشتغلوا في المهن الصعبة، وربما محيت هذه القصص من الكتب والصحف، أو ذابت بفعل الحساسية، والفورة النفطية، لكن ليس فيها إعتداء أو عنف.
عاملوا الناس الذين جاءوا من كل الخرائط بتقدير وإحترام، ومدارس العنصرية مفتوحة في بلدان كثيرة.
ليس لديهم ثروة النفط الكبيرة ولديهم الأسعار المرتفعة.
أمتصوا غضب الصحراء بمياههم الهادئة، وروضوها بأرضهم الصغيرة الناعمة.
مثل هذا الإنسان الذي يسعى للرزق تمتد إليه أيد؟
كان ينبغي أن تفتح له الأبواب التي تفتح للملايين من البشر من كل حدب وصوب!
يا ليت مؤسساتنا تهتم بهذا الإنسان، تحول حشود أولاد وبنات هذا البحار إلى مهندسين وتقنين تحتضنهم الشركات والورش.
يا ريت مؤسساتنا ووزارتنا تشغل من أبدع فيهم مسرحاً وتأليفاً في أجهزة هي بحاجة لهم وتطلب موظفين من خارج البلد!
نقول بأن في هذا البلد إمكانيات كبيرة، حقل زيتي لم يكتشف ويوظف هو هذه الطاقات الشعبية.
حلقي مليءٌ بالنارِ على وطني : عبـــــــدالله خلــــــــيفة
 عبدالله خليفة ..
عبدالله خليفة ..ابن الشعب وصوته
أيها الشابُ الواعدُ نضالاً ووطنية، أنت لا تعرف القضية!
نحن على مدى رمية حصاة من الحوت العسكري الفارسي النهم لأكل الأسماك البشرية الصغيرة، أنظرْ نحن لسنا من أصحاب الملايين، نحن كادحي كلمة فقراء، ناضلنا قبل أن تولد في قرية من أجل ناد يشرق بالتنوير على القرية.
وفي الحورة، ورأس الرمان، كتبنا، ومشينا للصحف البخيلة على أرجلنا، من أجل أن تنشر كلمة، أنت أيها الشاب خريطة الجراح، وأن تسلق الوطن والزمن في صحن الشعارات البريئة في فمك والتي تتحول إلى قذيفة في دمك.
أنظرْ أيدينا كيف غدت حصى من حجارة البلد، مزقتها قروشُ البر والبحر، وأوراقنا تغطي مساحة ملعب لكنك لم تقرأها، وجئت تعلمنا القضية.
حين ظهرت مكتبة قرب سوق (الظلام) بالتسمية الشعبية قام أحد رجال الدين ليغلقها، وكنا نشتري كتبها، وأخذوها وحرقوها، وجعلوك لا تقرأ ما فيها، وصحوت في آخر القرن بعد جفاف الحقول وكسل العقول، وأمسكت صارياً لسفينة تتجه نحو الشرق الاستبدادي لتعطينا بعض خبز الحرية.
شبابٌ ساذجٌ تربى في معسكر مغلق، سدوا منافذ النور فيه، ملأوا جسده بكراهية النساء، وإستعبادهن، ونشأ عجوزاً عقلاً فلم يعرف من الفكر سوى الصرخة الطائفية.
يداه لا تمتد للآلات والنظريات والرقص والشعر، علاقته بالوطن علاقة بعلم ملتصق بجسده لا بروحه.
ماذا تعرف عن هذا العلم الذي تحلمه؟ أنت تحمله كما حمل أصحاب صفين القرآين؛ قضيةُ حقٍ أُريد بها باطلٌ.
هل أنت بحريني؟ ماذا تعرف عن البحرين؟ هل عرفت ثوراتها وآدابها، هل قرأت قصصها، هل طفت بحاراتها، هل تشبعت نفسك المنفية عنا والمحبوسة في الدهليز المعتم بأشعارنِا وقصصنِا ورواياتنا ولوحاتنا وأمثالنا ومقالاتنا وكتبنا وأبحاثنا؟
ماذا تعرف عن البحرين؟ أيها الطيف، أيها السيف في أيدي أعدائنا؟
وحدة الماضي والمستقبل : عبـــــــدالله خلــــــــيفة
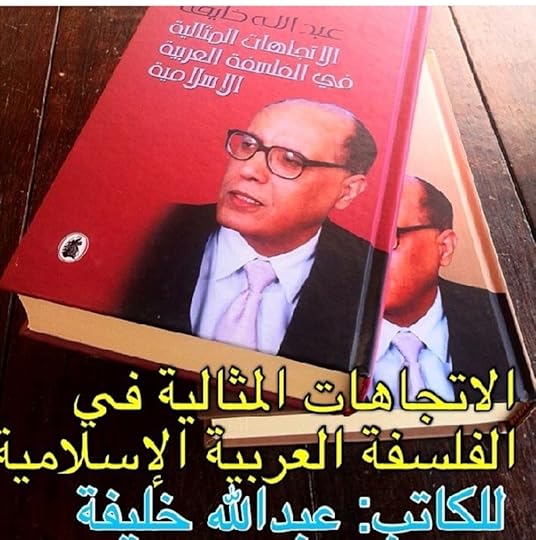 #عبدالله_خليفة
#عبدالله_خليفة
لا بد لك من جذور الشرق ومن تطور الغرب! لا تستطيع أن تعيش في الماضي ولا تستطيع أن تكون بلا ماضٍ! لا بد أن تجمعَ ما صنعتهُ من ضوءٍ ومجدٍ وتقدم في السابق، وأن لا تنعزل عن مجرى التقدم البشري، فالعالم لم يبدأ بك، ولن ينتهي فيك! وما أنتَ سوى لحظة من التاريخ، وقطرة في بحر الإنسانية، لكنك وقعتَ بين تخلفٍ شديد وتقدمٍ مخيف، فلا تقبل بهياكل مهترئة من الماضي يقدمونها إليك، فلا تكون لك إرادة ولا تكون لك حرية، كما فعل الاستغلاليون المتخلفون عبر التاريخ، فقادوا الأمة إلى أن تكون عربة محطمة في قطار التاريخ السريع، ولا تقبل أن تذوب في طوفان السلع الغربية لتعود مرة أخرى إلى الصحراء وقد فقدت نفطك وأبلك وحميرك! لكن الناس مهما تكن ثورتك ومحافظتك علبٌ من الماضي، مهما وضعوا الأضواء وديكورات الثياب والسيارات وتفننوا في الموضات فهم لا يختلفون عن الناس الذين عاشوا قبل مئات السنين، لا يزالون لا يؤمنون بإرادتهم، بل أزدادوا ضياعاً مع تحكم الرساميل الكبرى والدول ذات الجبروت بالبشر ينقلونهم من قارة إلى قارة كما يفعلون بالعرائس والحفاظات! أين الإنسان العربي من الإنسان الجاهلي قبل الإسلام الذي يقول : إذا بلغَ الرضيعُ منا فطاماً تخرُ له الجبابرةُ ساجدينا الآن إذا بلغ الشابُ منا جامعة وجدت ظهره منحنياً من الضرائب وتلوث الطرق والضمائر والجيوب، فهو منذ أن يتكون يخرُ ذلاً، ويزحف من أجل وظيفة، ويتوسل الراتب! ويسخر طرفة بن العبد من ملك الحيرة الذي جعل للناس يومين؛ يومٌ للطيور تطير فيها ويوم للناس تمشي على أقدامها، وإذا أحدٌ من الناس مشى في يوم الطيور ضرب، حتى جاء الشاعر عمرو بن كلثوم وقطع رأس هذا المتجبر! لا يأخذون من الماضي إلا القشور وزنازين الأفكار، ولا يأخذون من الحاضر إلا موضات الغرب الشكلية، فخسروا العصرين، ووحدة العصرين تتمثل في تأسيس حرية العربي في مبنى العلوم والحداثة
المسكراتُ وأحوالُ السياسة : عبـــــــدالله خلــــــــيفة
 المسكراتُ وأحوالُ السياسة
المسكراتُ وأحوالُ السياسة
لم تكن المرحلةُ الوثنيةُ الجاهلية تستدعي في مرحلة مكة الإسلامية المؤسسة، عمليةَ نقدِ شربِ الخمور، فقد كانت لها شعبيةٌ كاسحة، خاصةً مع الإحتفالات الطقوسية ذات الآلاف من السنوات، فكان النقدُ ينصبُ على عبادةِ الأوثان المُفكِّكة للعرب، والمؤدية لتمزقهم السياسي، وحين أخذت الدولةُ تتشكل في المدينة بخطواتٍ صغيرة، وبجهودٍ محاصرةٍ من قبل كثرة الأعداء الوثنيين واليهود وغيرهم، كان الأمرُ يدعو إلى تنامي الإنضباط العسكري لتلك القلة من المحاربين، ولما جاء في شرب الخمور لدى العرب البدو من فوضويةٍ وتخريبٍ حتى للمسجد الوحيد الذي ظهر في التاريخ.
كان لا بد هنا من التحريم السببي، وحين انتصر العربُ على أعدائِهم وتوسعتْ الدولةُ من مشارق الغرب إلى مغاربِها وإحتوت أمماً وشعوباً كثيرة، مالتْ سياساتُ الخلفاءِ للمرونةِ الاجتماعية مع هذه الشعوب وتقاليدها، ولم تُستخدمْ الأحكامُ الدينية الصارمة في مرحلة التأسيس، في مجالاتٍ عدة.
وجه الأئمة الكبار الأنظارَ السياسيةَ نحو الفساد السياسي بدرجة خاصة، وصعدوا الحريات الخاصة والعامة. فواقع الإنفتاح والثراء وغياب الأزمة الاجتماعية الحادة لم تستدعي التوجهَ إلى التشدد في الأحكام الجزئية وقضايا الحريات الخاصة، وهناك فرقٌ شاسعٌ بين أوضاعِ الفنون والحريات في زمنِ الجزيرة العربية البدوية وأوضاعها في زمن الحضارة والتعددية الاجتماعية السائدة وقتذاك!
لكن مع الأزمات في النظام السياسي الشمولي وعجزه عن تطوير حياة الأغلبية بل وإستغلالها ببشاعة، وتدهور أحوال الزراعة مصدر الإنتاج الرئيسي وهجرة المزارعين القرويين المعدمين للمدن، وهجمة البدو من الصحارى عليها، تدهورتْ الأحكامُ الفقهية، وتعالت أصواتُ المنع، بسببِ سيطرة ضيق الأفق على الكثيرين من رجال الدين، وعدم توغلهم في فهم أزمة المسلمين الحقيقية في النظام الاقتصادي وسوء توزيع الثروات في نظامِ الخلافةِ الاستبدادي البذخي، وسادتْ النصوصيةُ المقطوعةُ الجذور عن سيرورةِ تطور المسلمين وأهدافهم الجوهرية في التقدم الحضاري.
فكان المنعُ في الفترةِ الأولى والفترة الثانية مختلفين، فكان الأولُ من أجلِ النهضةِ والقفزة الحضارية وكان الآخرُ من أجلِ القمع وبسبب إنسداد الآفاق الحضارية ومجيء زمن الانحطاط. فكانت الأحكام ليست لانتشال الأمم الإسلامية من المأزق بل لزيادةِ غرقها فيه!
وقد بقيتْ رؤى محافظي زمنِ الإنحطاطِ مستمرةً بإعادات إنتاجها الضيق الأفق في فقهٍ نصوصي لا يرى أهمية توسع الحريات وربط المسلمين بالثورة الصناعية الأوربية المتفجرة، بل يرى وضع القيود على المسملين رجالاً ونساءً وإسدال الستار عليهم وعزلهم عن الثورة الحضارية والديمقراطية المندفعة في الغرب، فكانَ ذلكَ سبباً لغزو بلادِ المسلمين وإحتلالِ أراضيهم وسرقةِ ثرواتهم.
وبهذا فقد تم إسقاط السيطرات المحافظة الدينية من قبل الغرب المسيطر، ومن قبل جمهور المسلمين الذي فُجع بمستوى قياداتهِ الدينية والسياسية التقليدية وتخلفها، وعجزها عن الدفاع عن الدين والأرض.
فنشأت قوى جديدة إستلهمتْ الثقافةَ الإنسانيةَ الجديدة ومزجتها بإرثها السابق، ولم تتخلْ عن القضية، فنشأتْ حرياتٌ أوسع في كافةِ مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية، وهي التي ساهمتْ في طردِ المستعمرين وتحرير البلدان وإنهاض الشعوب العربية والإسلامية.
لكن القوى الاستعمارية والتقليدية وهي ترى عمليةَ إنهيارها من قوى الحداثة إستدعتْ الثقافةَ الدينية التقليدية الطوائفية وبعثتَها من القبور، وشجعتَها في كلِ مجالاتِ الحياة لتركيزها على ما هو تفريقي وما هو سطحي ومعرقل للنهضة الجذرية.
حدثت عمليةُ إنهيارٍ أخرى مشابهة لما حدث في أواخر الدولة العباسية بحدوثِ أزماتٍ عميقة في الدول العربية والإسلامية الشمولية، وتراجع القوى الحديثة وعدم طرحها حلولاً عميقة للأزمة، فقامت القوى التقليديةُ الطائفيةُ بالهروبِ إلى الإمام والقفز على سببياتِ الأزمات الحقيقية، بدءً من العودة لتطبيق الحدود عبر الفهم النصوصي الضيق الهروبي من القضايا كما حدث في بدء زمن الصعود الطائفي حتى قضايا منع المسكرات والحجر على العقول.
مع كل أزمة عميقة يتم تصعيد الدينيين المحافظين ويتم الابتعاد عن سببيات الأزمات وحلولها، وتفجير قضايا جانبية، خاصة مع تدفق القرويين والبدو على المدن، وإستخدام مستوى فهمهم لتوسيع القمع والتدخل في حياة الشعوب.
تركز القوى المحافظة الطائفية على الفهم الجزئي، والشكلاني المعزول عن سيرورة التاريخ وأسباب إنتاج الأحكام، وتغيبُ عنها مقاصدُ الشريعة الكلية في جعل الأمم الإسلامية متقدمة متحررة، فتقوم بتمزيق الصفوف، وترفيع ما هو ثانوي إلى درجة الكلي المطلق، فتدمرُ ما تريد بناءه، وتشل فاعلية الأمم، وتسهل بلعها من قبل الأعداء وتحلُ ضيقَ أفقِها أمام ثراء الوعي النهضوي الديني نفسه.
September 4, 2022
قليل من الموسيقى كثير من البهجة
موسيقى عمر الخيام لمحمد عبدالوهاب
غزو الفردوس لفانجيليس
كارمينا بورانا لكارل وراف

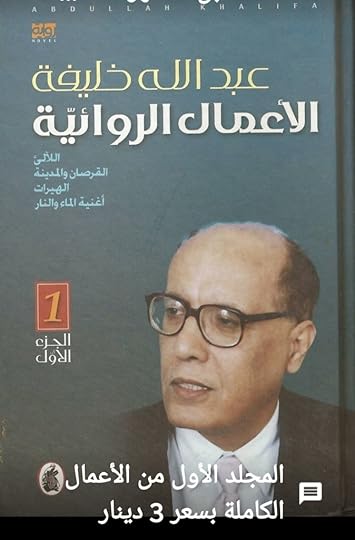
 القضيبية شارع طارق بن زياد طريق 2138 منزل 2521
القضيبية شارع طارق بن زياد طريق 2138 منزل 2521 

