مرام عبد الرحمن مكاوي's Blog, page 7
August 16, 2016
سوق عكاظ ومهرجان قريش
ما زال مهرجان سوق عكاظ في دورته العاشرة يحصد الاهتمام، وربما في هذه الدورة – التي لم أتمكن للأسف من تلبية دعوة كريمة إليها- حظي بتغطية أكبر من ذي قبل، وبمتابعة واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي. هذا المهرجان الذي يستحضر روح المكان وهيبة التاريخ، ويستلهم منهما ما يمكنه أن يعيد به تعريف نفسه ليكون مناسباً للزمن الحاضر، فيحتفي بالعلم كما الشعر، وبالتقنية كما الأدب، وبالفكر كما ريادة الأعمال، وكذلك بالإبداع والفنون بمختلف أشكالها، كالرسم والتصوير والفلكلور الشعبي. عكاظ هو هدية منطقة مكة المكرمة وإمارتها -التي تنظم وتشرف على المهرجان- للوطن بشكل خاص وللعرب بصفة عامة. فهل يمكن أن يكون هناك من يعترض على إقامة سوق عكاظ وشعاره “منتدى الحياة”؟
الإجابة للأسف نعم! وهو أمر يثير الاستغراب ولا يثيره في آن معاً. فقد تعودنا أن لكل مناسبة جميلة أو فعالية يتيمة في بلادنا، خاصة إن ارتبطت بالثقافة، أعداء، وهم أعداء الحياة والفرح، وأرباب ثقافة الكفن وفارشي التراب. وكأن الله خلقنا لنموت لا لنحيا ونعمر الأرض حتى يعلمنا عز وجل بأن مهمتنا انتهت ويقبض أرواحنا. من هذه الناحية لم تكن فكرة وجود معترض على سوق عكاظ غريبة. إنما الغريب في الموضوع هذه المرة، ليس استنكار الفئة التي تعترض على الاختلاط حتى في المسجد الحرام، وإنما أن يعترض أو يتحفظ عليه مثقفون ومعتدلون لأمور لا علاقة لها بالاختلاط والموسيقى، وإنما بدعاوى غريبة يكاد المرء لا يجد لها تصنيفاً منطقياً.
فبعد عشر دورات، تذكر البعض بأن عكاظ منتدى جاهلي، وأنه منتدى قريش – للعلم فُتحت مكة وأسلمت قريش كلها بحمد لله- وأنه يحيي تاريخ الجاهلية! وكأن الجاهلية هذه ليست جزءاً من التاريخ العربي، وليست جزءاً مهماً من تاريخ الجزيرة العربية التي تشغل المملكة العربية السعودية المساحة الأكبر منها. فهل كل أمور تلك الحقبة شر محض؟ ألم يقر الرسول صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق التي كان عليها العرب وقت بعثته، وبيّن أنه إنما جاء متمماً لها؟ ألم يبارك المصطفى حلفاً جاهلياً وهو حلف الفضول، وقال بأنه لو دعي إليه في الإسلام لأجاب؟
لا شك أن الرسالة المحمدية هي أعظم ما يمكن أن يحصل للعرب، وبها سادوا ونشروا العلم وصنعوا الحضارة، لكن هذا لا يعني أنهم لم يكونوا قبلها شيئاً مذكوراً. وإلا لما اختارهم الله ليخرج من بينهم آخر نبي ورسول، ولما كانت بلادهم القبلة والمحج، ولا صارت لغتهم لغة آخر الكتب وأشرفها. فهذا الجفاء وهذه العداوة مع التاريخ العربي قبل الإسلام من قبل عرب أقحاح أمرٌ غير مفهوم! أيمكن أن يذكر الشعر العربي دون المرور على امرؤ القيس أو زهير بن أبي سلمى وكلاهما من شعراء الجاهلية؟
أما الحجة الثانية، الأكثر غرابة، أن فيها تفضيلاً لمنطقة في المملكة على المناطق الأخرى، بتخصيص مهرجان يقام فيها. وكأن إقامة مهرجان في منطقة ما يمنع أخرى من القيام بالشيء نفسه. فإذا كانت إمارة منطقة مكة المكرمة اجتهدت وعملت لتنتج مهرجاً يحتفي بالوطن والتاريخ والثقافة والعلوم، وينعش المنطقة سياحياً، خاصة مدينة مثل الطائف التي كانت تسمى مصيف الملوك، وتراجعت في العقود الأخيرة مكانتها السياحية كثيراً، وها هي تحاول بجدارة استعادتها، خاصة بجوها الرائع في هذا الصيف اللاهب. إذا كانت إمارة مكة قد فعلت ذلك، فمن الذي يمنع البقية من إقامة مهرجان في منطقتهم، مستفيدين من تجربة مهرجان سوق عكاظ؟
الغريب أنه لم تكن هناك هذه الحساسية من مهرجان الجنادرية، فهو منذ ثلاثين سنة في الرياض دونما اعتراض. فلم يقل أحد إن الجنادرية هي مهرجان منطقة الرياض فقط، بل هو المهرجان الوطني للتراث والثقافة الذي نعتز به جميعاً. وبالمناسبة وجود مهرجانين للثقافة لم يؤثر على بعضهما سلباً، وها هما يستمران جنباً إلى جنب، دعماً للثقافة والمعرفة والفن. الطريف أن العرب قديماً، وهم يومها قبائل لا تجمعهم دول، وبعضهم بينه وبين قريش ثارات وعداوات، كانوا يشدون الرحال إلى عكاظ للتنافس الشعري في كل عام، بينما يعتبر مواطن سعودي الطائف بعيدة جغرافياً أو نفسياً؟
ويقدم المتحفظون لنا اقتراحات من أجل مهرجانات وطنية بديلة عن سوق عكاظ، إما في مدينة مكة المكرمة أو المدينة المنورة، لتكون احتفاء بالتاريخ الإسلامي، وكأن مكة والمدينة ينقصهما تعريف وترويج وسياحة. الازدحام فيهما كبير ما بين الزوار والمعتمرين والحجاج من الداخل والخارج، وباستثناء أن يكون المهرجان موجهاً لهذه الفئات بعينها، فإنه من الأفضل إبعاده عن المناطق المزدحمة مثل المدينتين المقدستين ومثل جدة والرياض.
هذا الجدل حول سوق عكاظ، أخذني إلى أبعاد أعمق، وذكرني بمواقف أخرى، كان يُطلب منا أن نفعل هذا الشيء أو لا نفعله، بدعاوى الولاء. فهناك من ناحية الوطنيون المتعصبون الذين يعتقدون بأن اهتمامك بقضية إسلامية، أو احتفاءك بإنجاز لدولة أو فرد مسلم، يتعارض مع كونك سعودياً، فاهتمامك وحبك يجب أن يكون لوطنك السعودي وأهله فقط. ومن ناحية أخرى الأمميون الذين يعتقدون بأن افتخارك بوطنك، واحتفاءك بنشيده الوطني وبمنجزاته وتاريخه، إنما يتعارض مع انتمائك لأمة الإسلام. والفريقان على ما يبدو لديهما مشكلة في اعتزازك بعروبتك وبتاريخك العربي قديماً وحديثاً. فهل المطلوب أن تكون سعودياً أو عربياً أو مسلماً في الانتماء والولاء؟
في الواقع لا يمكن للمرء إلا أن يكون هذه الثلاثة معاً، فكل منها يمنحك جزءاً من هويتك وشيئاً من شخصيتك، وبدون أحدها سيكون هناك نقص وعدم توازن. فجيناتك عربية وكذلك لغتك، وإيمانك ومعتقدك يجعلانك مسلماً، ووطنك حيث تعيش وتنتمي قلبياً وجغرافياً ورسمياً، ومن الطبيعي أن تعتز وتنتمي لكل واحد من هذه العناصر، لأنه لا تعارض بين هذه الانتماءات الثلاثة أصلاً. وهناك انتماء أكبر للبشرية وللإنسانية، فالله جعلك قطرة من محيط كبير فلمَ تختر أن تكون قطرة في كأس صغير؟
August 11, 2016
اصنع مستقبلك
 عندما بدأ البشر يستقرون ظهر مصطلح الوظيفة، حيث يعلم الناس في أعمال محددة، إما توارثوها عن أجدادهم أو تعلموها من غيرهم. ومع ظهور التعليم النظامي كانت الطريقة المثلى لدى الآباء لتأمين مستقبل جيد لأطفالهم هي إرسالهم لأفضل المتاح من المدارس والمعاهد والجامعات. وبعد التخرج سيعملون في وظائف تعتمد على تخصصاتهم، وسيبقون فيها حتى التقاعد. لكن من النادر جداً أن يكّون هؤلاء ثروة طائلة في بداية حياتهم المهنية، ما لم يكونوا أبناء عائلات ثرية تدعمهم لبدء عمل تجاري. أما في عالم اليوم فلم يعد هذا السيناريو منطبقاً على الجميع.
عندما بدأ البشر يستقرون ظهر مصطلح الوظيفة، حيث يعلم الناس في أعمال محددة، إما توارثوها عن أجدادهم أو تعلموها من غيرهم. ومع ظهور التعليم النظامي كانت الطريقة المثلى لدى الآباء لتأمين مستقبل جيد لأطفالهم هي إرسالهم لأفضل المتاح من المدارس والمعاهد والجامعات. وبعد التخرج سيعملون في وظائف تعتمد على تخصصاتهم، وسيبقون فيها حتى التقاعد. لكن من النادر جداً أن يكّون هؤلاء ثروة طائلة في بداية حياتهم المهنية، ما لم يكونوا أبناء عائلات ثرية تدعمهم لبدء عمل تجاري. أما في عالم اليوم فلم يعد هذا السيناريو منطبقاً على الجميع.
فلم يعد الأشخاص بالضرورة يعملون في وظيفة واحدة فقط، ولم يعودوا مجبرين على العمل في تخصصاتهم. فليس غريباً أن تصادف شخصاً درس الفيزياء في الجامعة، لكنه يعمل في العلاقات العامة، لتميزه في مهارات التواصل والاتصال، وهو كذلك يصمم الهويات التجارية للشركات، ويقوم ببناء مواقع الإنترنت للأفراد. وهذه المهن المتعددة التي يقوم بها تحقق له دخلاً (ومتعة!) أكثر بكثير فيما لو اكتفى بوظيفة محددة.
وأعرف زميلة خريجة تخصص تقليدي، لديها عملها الخاص كمصممة أزياء نسائية، وتعمل مذيعة غير متفرغة، وتمارس الكتابة. وعملها على هذا النحو ربما لا يحقق لها الراتب الثابت والمزايا فيما لو عملت كمعلمة أو موظفة إدارية في القطاع الخاص، لكنه يمنحها أموراً أخرى كالاستقلالية في اختيار ما يناسبها، والمرونة في ساعات العمل، وهذا أمرٌ مهم جداً بالنسبة لها كونها زوجة وأم لأطفال صغار.
فالفكرة الأساسية ليست أن تزهد في الوظيفة، أو أن تعمل في عدة مهام لا علاقة لها ببعضها، وإنما أن ترى المستقبل لك ولأطفالك بصورة مختلفة. فهناك وظائف وأعمال لا يمكن ممارستها إلا بالتخصص مثل الطب والتمريض والطيران وبعض فروع الهندسة والتعليم، ولكن ينبغي أن تكتفي بعمل واحد فقط؟ أو أنه يجب أن يكون لك مسمى وظيفي محدد؟
أستغرب عندما أقرأ نصائح البعض للطلبة والشباب هنا في المنطقة العربية بأن يكتفوا بذكر أشياء محددة ومترابطة في السيرة الذاتية، وأن يتركوا خارجها أعمالاً أو هويات مارسوها وباتت لديهم خبرة فيها. فهذا عكس ما كان يقال لنا في بريطانيا، بأن الاكتفاء بذكر التعليم والوظائف في السيرة الذاتية يجعلها عادية ومملة. فما يجعلها مميزة، وبالتالي ما يجعل صاحبها موضع الاهتمام، هي كل تلك الأمور الإضافية التي تختلف من شخص لآخر، والتي تبرز المهارات الأخرى التي لن تظهر على الورق إلا من خلالها، مثل التواصل أو الإبداع أو التفاوض. وفي كل مقابلة وظيفية أجريتها في بريطانيا مع شركات كبرى مثل شل (التي انتهى بي العمل لديها) وIBM وHP وشارب، فإن أكثر الأسئلة كانت تدور حول نشاطاتي التطوعية واللا صفية أكثر مما كانت تدور عن لغات البرمجة التي أجيدها أو عن رسالة الدكتوراه الطويلة!
الكثير من الشركات العالمية اليوم، وخاصة تلك التي تشجع وتعتمد على التقنية والابتكار، وتحديداً في مجال تقنية المعلومات وتطبيقاتها، تحتار في المسميات الوظيفية التي تمنحها لأفرادها الأكثر تميزاً، والذين سعت لاستقطابهم لكونهم متعددي المهارات، ويغطون، بطريقة مبتكرة، تلك الاحتياجات الوظيفية التي لا يمكن تحديدها مسبقاً. فهم من يصنعون وظيفتهم الخاصة ويبتكرون الأفكار الخلاقة التي يمكن أن تكسب الشركات ملايين الدولارات. وإذا كان بعضهم، رغم تميزه وتعدد مهاراته، يختار العمل في شركة رائدة تقدر مهاراته المختلفة والمتقاطعة في آن واحد، فإن غيره لديه من الإمكانات الإبداعية والتقنية التي تجعله ينشئ بيئة عمله الخاصة التي ستجعله مليارديراً وهو بعد على سلم العشرين مثل مارك زوكبرغ مبتكر الفيسبوك.
وليس مارك وحده بدعاً عن غيره فهناك جاك دورسي مؤسس تويتر، وجيف بيزوس مؤسس شركة أمازون وغيرهم ممن كونوا ثرواتهم في أعمار صغيرة لأنهم كانوا يملكون أفكاراً جيدة، ولديهم القدرة على تحويلها إلى منتجات ملموسة يستخدمها ملايين الناس. ومن قصصهم نتعلم كم هو مهم تعلم برمجة الحاسوب مثلاً، حتى لو لم يكن الشخص متخصصاً في علوم الحاسبات، فهي ستفتح له أبواباً لأفكار خلاقة في مجال ريادة الأعمال. بالإضافة إلى أن تصميم البرمجيات وكتابة الشيفرة البرمجية يعلم الفرد مهارات مهمة أخرى: التفكير المنطقي وحل المشكلات. وهي مهارات يحتاجها الإنسان ويستخدمها في قطاعات مختلفة من الحياة من الطب إلى العمارة، ومن الحقوق إلى السياسة. وإذا كانت هذه المهارات كانت دائماً مطلوبة، فإن الحاجة لها تتضاعف في عالم اليوم وفي المستقبل أيضاً، لتعدد الخيارات، وتداخل المشكلات، وزيادة التنافس، والرغبة الملحة في تحقيق العدالة الاجتماعية.
العلوم تتطور والمعرفة تتغير، وباستثناء بعض القواعد الأساسية الثابتة في الرياضيات والعلوم الطبيعية والشرعية، فإن ما نتعلمه اليوم سيصبح في وقت غير بعيد منتهي الصلاحية. وبالتالي فإن التعليم القائم على الحفظ، وعلى حشو الطلبة بأكبر كم من المعلومات لم يعد مجدياً بأي لغة كان. فالتعلم المستمر أو التعلم مدى الحياة هو المتوقع اليوم من الفرد ليواكب التطورات ويظل مغرياً للتوظيف من قبل الشركات التي بات يهمها مدى قدرة موظفيها على التعلم مستقبلاً وليس على ما يعرفونه الآن.
ويبرز سؤال الأهالي هنا، مع اتجاه العالم بعيداً عن التخصص، هو: ما الذي يجب أن يتعلمه طفلي إذاً؟
الخبراء يقولون يجب أن يتعلم بالطبع المهارات الأساسية: القراءة والكتابة -بلغته الأم- والحساب، لكنه يحتاج أيضاً إلى معرفة إحدى اللغات الأوروبية الفاعلة، وهي غالباً الإنجليزية أو الفرنسية، ومعها اللغة الصينية، فالمستقبل في الصين. وكذلك تعلم مبادئ برمجة الحاسوب، وكيفية تحليل البيانات الهائلة، والتفكير المنطقي. والأهم من ذلك كيف يتعلم مهارة جديدة؟ كيف يتأقلم مع بيئة عملية اجتماعية متغيرة بشكل يتسارع؟ كيف يبحث عن المعلومة من مصدرها؟ وذلك لن يتحقق دون مهارة القراءة الحرة. أيضاً أن يتعلم كيف ينفتح على الأفكار غير التقليدية، ويتقبل اختلاف الآراء والثقافات، مع اعتزازه بهويته وتاريخه ودينه وثقافته.
فالبصارون الذين يقرؤون المستقبل بناء على ما يتوافر من حقائق علمية وخيال ذكي، يخبروننا بأنه خلال العشرين سنة المقبلة ستتغير طريقة حياتنا ودراستنا وعلاجنا وترفيهنا وعملنا بشكل جذري. وبأن التغير حتمي، والبكاء على الماضي لا يجدي، وإنما لا يبقى إلا الاستعداد للمستقبل بشكل صحيح، ليجعلنا قادرين على وضع بلادنا وأولادنا في مكان لائق تحت الشمس.
August 4, 2016
انتق واختر لكن تحمل نتائج القرار
تربية الأبناء مسؤولية جسيمة، والحياة اختيارات، وما تزرعه في الصغر، ستحصده في الكبر، فحتى اختياراتك في التربية والتعليم داخل الوطن ستؤثر على دينه ولغته ونوعية أصدقائه. فعليك أن تدرس خياراتك جيدا
تتباين مواقفنا من نظام الحياة الغربي الذي يحترم الحرية الفردية مهما بلغت، والذي يوفر أسلوب حياة متقدم فيه الكثير من الرفاهية في الصحة والتعليم والترفيه وغيرها من نواحي الحياة المختلفة. هذه المواقف تتراوح بين الانبهار الشديد والمقت العميق. فالمنبهرون بالنظام والنظافة والعدالة، يكادون يتغاضون، أو يغضون الطرف، عن الجوانب السلبية في تلك الحضارة، كتلك التي تبيح المثلية الجنسية وغيرها. في المقابل فريق الكارهين والماقتين لا يريد أن يرى شيئاً من الأنظمة العادلة التي تحفظ الحقوق للنساء والأطفال والضعفاء وكافة أفراد المجتمع، ولا يعترف بالمنجزات العلمية والثقافية المبهرة. وتظل الأغلبية ربما في حال وسط: يرى الإيجابيات ويحاول الاستفادة منها عبر التعليم والصحة والتجارة والسياحة، ويحاول ما استطاع تجنب السلبيات التي لا تتوافق مع قيمه ودينه ومعتقداته.
كل هذه المواقف الثلاثة مقبولة في حال كان المواطن العربي أو المسلم طارئاً (مبتعث، مريض، سائح، إلخ) على تلك البلدان لتحقيق هدف معين، فيلتزم بالقوانين والنظام ما دام فيها حتى تنتهي حاجته. لكن ماذا لو اختار ألا يكون طارئاً؟ أي اختار المواطنة لنفسه وأسرته في تلك البلدان الغربية؟ هل يستطيع أن ينتقي أو يختار من قوانينها وقيمها ما يعجبه؟
نشرت صحيفة عكاظ بتاريخ الأحد (31 يوليو 2016) بعنوان: “لندن: المحكمة العليا ترفض طلب سعودي منع نشر نزاعه مع ابنته”. ومما جاء في الخبر المقتضب بأن ثمة والداً سعودياً يواجه قضية مرفوعة عليه هناك من قبل ابنته (21 عاماً) بتهمة احتجازها في جدة منذ أربع سنوات، في حين عادت بقية الأسرة والأبناء إلى بيتهم وبلدهم الذي ولدوا وعاشوا فيه طوال حياتهم ويحملون جنسيته (جنسية مزدوجة سعودية – بريطانية) في جنوب مقاطعة ويلز البريطانية. ووسط هذه التهمة من العيار الثقيل “احتجاز مواطنة بريطانية قاصر بداية وراشدة حالياً ضد رغبتها” والتي يمكن أن تكون عقوبتها وخيمة، فإن الأكاديمي الستيني، ما زال بعقليته العربية يعتقد بأن المشكلة الأهم هو ألا يعلم بها أحد! وجاء الرد من القاضي الإنجليزي بالرفض، وبحسب صحيفة عكاظ: “وأضاف أن نشر الأخبار بلا قيود يمثل أساس المجتمع الديمقراطي”. ولم يتسن الحصول على المزيد من المعلومات حول القضية التي تمس كذلك حياة مواطنة “سعودية” من الصحف السعودية، ولذلك فقد تم الحصول على بقية المعلومات من الصحف البريطانية، التي اهتمت -ولا شك- بإبرازها.
القضية باختصار هي أن أكاديمياً سعودياً، يعمل في المملكة أنجب تسعة أبناء في المملكة المتحدة، من زوجة لسنا متأكدين من جنسيتها، وحرص على بقائهم جميعاً هناك ليحصلوا على الجنسية البريطانية، ويتعلموا، ويتعالجوا على حساب الدولة البريطانية، ويحصلوا على الإعانات التي يحصل عليها الأطفال من الدولة. فالفتاة التي رفعت الدعوة عاشت منذ الولادة وحتى عمر الستة عشرة في مقاطعة ويلز. وحقيقة لا نعرف حجم المتابعة من قبله وقبل زوجته لأبنائهما خلال حياتهما في المجتمع الغربي، الذي باتوا ينتمون إليه قانونياً وثقافياً، ويبدو أنها كانت تعيش مرحلة المراهقة مثل أي فتاة بريطانية في سنها. غريباً أن تتأثر بأقرانها. وهنا استيقظ الأب متأخراً، وبدل أن يتدارك أخطاء الماضي، ويحاول بالحسنى والإقناع بيان ذلك الخطأ لابنته، اختار اختطافها (في العرف الغربي) والعودة بها إلى جدة.
في جدة كان يُفترض أن يحسن معاملتها ويحاول جذبها إلى الحياة في الوطن والعائلة، لكن ما ذُكر في التقرير – إن صدق ولم تكن فيه بهارات غربية- فإنها تزعم بأنها تعرضت للتعنيف وحلق شعر رأسها الطويل، ووضعها في غرفة أشبه بالسجن ومغلق عليها بالحديد. وبعد أربع سنوات لم تلجأ للسلطات المحلية، التي ربما لا تعرف حتى لغتهم، وإنما للقنصلية البريطانية في المملكة. وبحسب ما ذُكر في عكاظ فقد اعترف الأب ببعض ما نُسب إليه.
أربع سنوات لم تجعلها تتأقلم، خاصة أن الأب لم يقم بإعادة بقية الأبناء والعائلة منعاً لحصول فضيحة جديدة، وإنما هؤلاء جميعاً عادوا لحيواتهم ودراستهم في ويلز، أي أنه ما زال يستفيد من النظام البريطاني والدولة البريطانية، وهو الذي يقول على لسان محاميه، في معرض دفاعه عن موقفه في رفضه إعادة ابنته إلى بريطانيا، بأنه لا يرغب في أن تعود لنمط حياتها السيئ، ولجو الحياة المسموم هناك!
صديقنا الدكتور الجامعي وقع في معضلة الازدواجية المقيتة، هو يريد الاستفادة من النظام البريطاني الجيد تعليمياً وصحياً، لكنه في الوقت نفسه يحتقر المجتمع البريطاني، ويعتبره مسموماً، وليس سعيداً ليس فقط بأسلوب الحياة المتحرر، وإنما حتى بجو الحرية والشفافية، بدليل تقدمه بطلب لحجب المعلومات الخاصة بقضيته عن الإعلام، وهذا أمر شبه مستحيل في الصحافة الغربية. وبسبب موجات التطرف والإرهاب التي ترتدي ثوب الغلو والتشدد الديني، بات الناس يخشون على أولادهم من التطرف الجهادي، ومن الاستقطاب من قبل الجماعات الإرهابية، لكنهم نسوا أو تناسوا، بأن هناك تطرفاً في الاتجاه المعاكس.
تربية الأبناء أمانة عظيمة، ومسؤولية جسيمة، والحياة اختيارات، وما تزرعه في الصغر، ستحصده في الكبر -مع استثناءات قليلة- فحتى اختياراتك في التربية والتعليم داخل الوطن ستؤثر على دينه ولغته ونوعية أصدقائه. فعليك أن تدرس خياراتك جيداً، وتعرف بأن كل خيار له شروطه، وتترتب عليه نتائج قد لا تظهر إلا بعد عشرين سنة، فإما أن تقبل بقواعد اللعبة وكافة احتمالاتها قبل أن تبدأ، أو لا تقبلها من الأساس.
July 27, 2016
ماذا يمكن أن يعلمنا الأطفال؟
خلال القرن العشرين وما تلاه شهدت البشرية تقدماً ملحوظاً في كافة مناحي الحياة، وتم اختراع العديد من الأجهزة التي يُفترض أن تسهل حياتنا. وعاش الإنسان في البداية منتشياً تحت تأثير مخدرات الرفاهية، وأسكره ذلك الإحساس الجميل بالتقدم، إلا أنه سرعان ما لاحظ أنه وقع في ورطة! فثمن الحياة المرفهة كان فقدن البساطة وراحة البال التي تأتي معها.
إذ اكتشف بأنه تسبب في تعقيد وتوتير حياته بشكل غير مسبوق. فقد صارت لديه العديد من الأجهزة التي لا يحتاجها، وإن احتاجها فلا يعرف كيف يستخدمها، وفي كل يوم يجابه بكم كبير من التعليمات التي لا يعلم كيف يمكنه اتباعها، وعليه تعبئة العديد النماذج المختلفة التي لا يفهمها. فكل جانب من جوانب حياتنا، حتى التسلية والترفيه، أصبح معقداً ومربكاً بوجود العديد من الخيارات المتاحة والمتزايدة بوتيرة محمومة. والمعضلة الأكبر هو أنه بات أسيراً لهذا النوع من طريقة العيش، فما عاد يرضى بغيرها مع إدراكه التام بتسببها في توتره وقلقه وزيادة مخاوفه وربما أمراضه.
وباتت بعض المشكلات التي يفترض أن تكون سهلة، عصية على الفهم والحل، فهو أدمن التعقيد، حتى باتت طريقة تفكيره معقدة، فتعجز عن رؤية أقرب وأبسط الحلول أحيانا.
ويبقى الأطفال، مع أنهم من سكان هذا الكوكب، إلا أنهم ما زال لديهم بقايا معرفة نسيها الكبار. فالأطفال أكثر شجاعة وثقة في حل مشكلاتهم اليومية البسيطة، ويستمتعون بشكل أكبر بكثير من الكبار. وإنه ليبدو من العجيب أحياناً أن ينتهي بالراشدين، في رحلة البحث عن البساطة المفقودة، أن يجدوا أنفسهم وقد عادوا لطفولتهم الأولى. فماذا يمكن أن يعلمنا الصغار؟
في كتابها الجميل:” أشياء مهمة علمني إياها أطفالي” تستخلص سنثيا كوبلاند بعض هذه العبر الطفولية التي يمكن أن نستفيد منها في حياتنا اليومية، وقد اخترت منها:
1. إن اشتداد الرياح يعني بأن طائرتك الورقية ستحلق إلى مدى أعلى.
2. إذا أردت الحصول على قطة فأبدأ بطلب حصان!
3. عليك أن تأكل نصف علبة رقائق الإفطار قبل أن تجد اللعبة المجانية المرفقة.
4. حتى الأطفال الذين بالكاد تعلموا الوقوف يحاولون الوصول إلى أشياء على ارتفاعات أطول من قاماتهم.
5. لا تتوقف عن المشاركة في اللعب حتى تنتهي اللعبة فعلياً.
6. حينما تبني قصرك بالمكعبات تذكر أن تكون القاعدة دائماً أعرض وأشمل من القمة.
7. أشعل كشافك وأفحص ما تحت السرير.
8. ما دامت ثيابك قد تبللت فلا يهم كم سيستمر هطول المطر..استمتع!
9. العب معهم بدل أن تتفرج عليهم.
10. إذا انتظرت حتى تكون مستعداً تماماً فلن تنزع أبداً عجلات الدراجة المساندة.
ويمكنك أنت أيضاً أن تنظر حولك وتسأل نفسك: ماذا علمك أطفالك؟ أو ماذا تستطيع أن تتعلم من الأطفال من حولك؟
العرب والسياسة بين المبدأ والهوى
في أوقات الراحة والدعة يدعي كثير منا تمسكه بالمبادئ السامية والقيم النبيلة، لكنها الأوقات الصعبة والأحداث الجسيمة هي التي تضعنا في مواجهة حقيقية مع هذه الأسس التي ألزمنا أنفسنا بها. بحسب ويكبيديا العربية فإن المبدأ هو: “النقطة الأولى التي ينطلق منها تفكير الإنسان، ومنها يمكن تحديد ما هو الصواب والخطأ. وبالتالي يمكن للإنسان أن يتخذ قراره وفقا لما توصل إليه من نتائج، وطبقا لمدى تمسكه وإيمانه بضرورة تنفيذ ما لا يتعارض مع مبدئه”، فهل مجتمعاتنا العربية بصفة عامة، ومثقفونا بصفة خاصة، ملتزمون بمبادئ لا يحيدون عنها أم أن مجرد حضور الهوى كفيل بنسف هذه المبادئ؟
لنأخذ الأحداث التركية الأخيرة، أي الانقلاب العسكري الفاشل الذي كاد يهز المنطقة بأسرها وليس الجمهورية التركية وحدها، سنجد أن المبدأ والمنطق والشرع يرفضون الخروج على الحاكم، خاصة أن الحكم ديمقراطي والرجل منتخب، ويرفضون الإخلال بالأمن، ونشر الفوضى والانقسام، وإعطاء فراغ في السلطة يمكن أن يستغل من قبل الجماعات الإرهابية. لذلك كان يفترض أن تكون ردود الأفعال في الإعلام العربي الرسمي والشعبي متقاربة ورافضة، لكن للأسف كان ذلك أبعد ما يكون عن الواقع. فقد وجدنا تطرفا على أقصى نقيضين: فهناك من اعتبر الانقلاب فتحا من الله وهلل وكبر له قبل أن يخيب أمله لاحقا بالكيفية التي انتهى إليها، وهناك من اعتبره في الطرف المقابل إشارة السماء إلى عظمة الحكومة التركية وقائدها. والسبب في هذين الموقفين المتناقضين هو أنهما بنيا بشكل أساسي استنادا على المشاعر من الرئيس التركي: رجب طيب إردوغان.
موقف “العرب” من الرئيس “التركي” محير بالفعل! فهناك من يراه المهدي المنتظر في مقابل من يعتقد على ما يبدو بأنه المسيح الدجال! أحدهم يراه أقرب ما يكون لخليفة المسلمين في العصر الحالي، وسيحاولون تبرير ما لا يبرر له من مواقف سياسية أو شخصية، وهي المواقف ذاتها التي لا يقبلونها من حكومات بلدانهم العربية. وآخر العكس تماما، فيراه منافقا متآمرا على الأمة لتحقيق أغراض حزبية ضيقة، أو زعامة غير مستحقة للعالم الإسلامي، أو بسط نفوذ توسعي تقوده أحلام الخلافة العثمانية. وينسفون أي إنجاز سياسي أو اقتصادي ملموس للرجل على أرض الواقع. ويتناسى كلا الفريقين أن السيد إردوغان في البداية والنهاية رئيس للجمهورية التركية، وقد وصل إلى السلطة بأصوات الناخبين الأتراك القادرين على عزله في الانتخابات المقبلة فيما لو شعروا بأنه لا يلبي متطلباتهم المحلية التي يريدها كل شعب: عدالة اجتماعية وحقوق إنسان واقتصاد قوي ونهضة في التعليم والصحة والصناعة، وغيرها من قطاعات الدولة الحيوية.
السؤال هنا: ما الدوافع التي تحرك كلا الفريقين وأدت إلى هذه المشاعر المتناقضة بين الحب الجارف والكره العميق؟
بالنسبة لفريق المحبين فلعله اليأس من الأوضاع التي آلت إليها الأمور في المنطقة بعد 5 أعوام من الكابوس العربي، وكذلك الأمل القديم الجديد بأن حال الأمة لا ينصلح إلا بفرد لديه عصا سحرية يحقق بها المعجزات ويعيد لها عزتها وكرامتها. هؤلاء ضحايا كتب التاريخ العربية التي لا تتحدث إلا عن الأفراد الأبطال مثل صلاح الدين الأيوبي والسلطان محمد الفاتح وغيرهما. لا تتحدث عمن ساعدهم ودعمهم، ولا عن أمة ناهضة يقوم كل فرد فيها بواجبه في بناء الحضارة وصناعة التاريخ. هؤلاء أعجبوا سابقا بسفاحين وديكتاتوريين وصلوا للحكم بانقلابات عسكرية، ويبدو أنهم لم يتعلموا شيئا من الخيبات المتوالية والكوارث الكونية التي تسبب بها هؤلاء، فهم يحتاجون جرعة وعي للعودة للواقع.
أما فرق الكارهين فحالهم أكثر سوءا، لأن هؤلاء مصابون بمتلازمة “الإخوان المسلمون” الذين يعتبرون بأن الرئيس التركي ينتمي لها. هؤلاء يلمحون أشباح الإخوان وفكرهم في كواكب الفضاء ونجوم السماء وقيعان المحيطات! يكفي أن تختلف معهم في موقف سياسي أو فكري حتى تأتيك التهمة المعلبة: “إخواني!”. وبالرغم من أن حركة الإخوان قد تلقت أقوى الضربات في تاريخها في مصر عقر دارها، فرئيسها المنتخب محكوم بالمؤبد، ومرشدها في السجن مع جل قيادتها، وتم تجريم الحزب والانتماء إليه في الكثير من الدول العربية، وبات الجميع يحاول النأي بنفسه عنها، ومع ذلك فإن الجماعة لا توال تشكل فزاعة للكثيرين بشكل يستدعي ربما الذهاب إلى طبيب نفسي. بعض هؤلاء مستعدون أن يجدوا خيرا في أفعال نتنياهو، وأن يمتدحوا ديمقراطية الكيان الصهيوني، ولكنهم لا يستطيعون فعل الشيء نفسه مع أي حزب إسلامي يصل للسلطة ويحقق نجاحات سياسية أو اجتماعية.
ما حصل في تركيا قبل عدة أيام واضح، ولا يفترض أن يختلف عليه صاحب مبدأ، الديمقراطية -في الدول التي اختارتها طريقها- هي اختيار الشعب، والانقلابات العسكرية، في الشرق والغرب، عليها هي انقلاب على الشرعية وعلى خيار الشعب، وبغض النظر عمن يجلس في سدة الحكم ومن يقود الانقلاب، فهي خطأ لا يأتي بخير إلا في حالات نادرة جدا. فالعسكر لم يخلقوا للحكم ولا يجيدونه، وسيذكر التاريخ الرئيس السوداني عبدالرحمن سوار الذهب كأشرف رئيس عسكري، فقد تولى الحكم حين لزم الأمر لكنه سرعان ما سلم السلطة مختارا بعد ذلك بعام إلى الرئيس المنتخب، هنا رئيس وطني حقيقي وعسكري شجاع يعرف أن مكانه ليس على كرسي الحكم.
وإذا كانت الانقلابات العسكرية بصفة عامة مذمومة، فهي في الحالة التركية أشد ذما، لأنه لا مبرر لها داخليا أو خارجيا، فداخليا إنجازات الرئيس إردوغان وحزبه تتحدث بالأرقام وبدون دعاية عن النقلة التي صنعت في تركيا في هذا العهد، وخارجيا وجود دولة تركية قوية ومستقرة بقيادة حكومة معتدلة ضرورة لمواجهات الدول المشاغبة في المنطقة كسورية وإيران والعراق، وأيضا جماعات الذبح والحرق والنحر والسبي كداعش. هذه الأسباب هي التي جعلت الأغلبية الساحقة من العرب يرفضون الانقلاب ويفرحون لدحره، ولذلك من المعيب أن نجد من يتهم هؤلاء المواطنين الشرفاء بأنهم طابور خامس، أو بأنهم يوالون غير بلدانهم، أو يعترضون أصلا على متابعتهم للشأن التركي!
كل الأمور تتغير، ولكن المبادئ هي التي يجب أن تثبت، فهي الظل الوحيد في صحراء هائلة ستشعر بالأمان وأنت تحتمي فيه حينما تسود الفوضى واللامنطق، وقد تكون وحيدا هناك، وحيدا جدا، لكنك ستكون قد خسرت العالم وكسبت نفسك.
June 12, 2016
التعليم كوسيلة للتمييز الطبقي
قد يبدو هذا العنوان غريباً بل وصادماً للبعض، فيفترض بأن العكس هو الصحيح، فقد علمونا صغاراً:
” العلم يرفع بيوتاً لا أساس لها والجهل يهدم بيت العز والشرف”. بل مازال كثيرٌ من المصريين يدينون بحصولهم على الفرصة التعليمية لثورة يوليو التي قام بها الضباط الأحرار، والتي جعلت التعليم المجاني متاحاً لأبناء الفلاحين، بينما كان متاحاً لأبناء الباشوات وعلية القوم فقط إبان العهد الملكي. أما في المملكة فالكثير من أعيان البلد ووزرائها ومسؤولياتها جاؤوا من خلفيات متواضعة وأسر متعففة لكن العلم صنع الفرق في حياتهم ونقلهم من حال إلى حال. فلماذا إذاً نخشى الآن بأنه قد يكون سبباً في حصول العكس؟
قبل أن أصبح أماً كنت أسمع عن المبالغ الفلكية التي تُدفع في المدارس الأهلية، وخاصة العالمية منها، والتي كنت من أوائل من انتقد السماح في الدراسة بها للسعوديين، لعدة أسباب، لكنها باتت واقعاً لا يمكن تجاهله، بل تكاد لا تجد مدرسة خاصة لا تطبق نوعاً من التعليم باللغة الأجنبية، وكان ذلك مبرراً إضافياً لرفع رسومها في ظل صمت ومباركة وزارة التعليم.
عندما أصبحت أماً عاملة، وحين تفاجأت من رد جامعتي التي أعمل بها بأن الأولوية في الحضانة ليست لعضوات هيئة التدريس، بدأت في التفكير في البدائل، التي لم تكن – بسبب الموقع الجغرافي بين بيتي ومقر عملي وأماكن هذه الحضانات-كثيرة. فانتهى الحال بصغيري بأن يبقى مع والدتي – حفظها الله-التي تحملت الكثير خاصة في ظل أزمة الاستقدام، وذلك حتى بلغ العامين -بحمد الله-في نهاية شهر شعبان من هذا العام. لكن بدأت في الاستعداد للعام القادم بالبحث عن حضانة مناسبة لنا معاً. قمت برحلات مكوكية لأكثر من عشرة مدارس في أحياء مختلفة من المدينة، واتصلت بعدد آخر ممن لم يحمسني الاتصال بهم لاتباعها بزيارة. وخرجت من هذه الزيارات ببعض القناعات:
1- الأسعار غالية جداً بالنسبة للطبقة المتوسطة، بل وحتى للطبقة المتوسطة العليا (أساتذة الجامعات، والأطباء، والمهندسين والمحامين) ممن لديهم في الغالب أكثر من طفل. أسعار الروضات السنوية تراوحت ما بين 9000 آلاف – 30000 ألفاً للأعمار ما بين شهرين – خمس سنوات.
2- حضانات وروضات مرحلة ما قبل المدرسة، تكاد تكون كلها تتبع نظام التعليم العالمي (الانترنشونال) أو التعليم الأجنبي الخالص (تابعة لدول بعينها).
3- في حالة وجود حضانات عربية (أتحدث عن تلك التي زرتها) وجدتها تقليدية جداً، ومستوى الرعاية والاهتمام بالأطفال دون المقبول بالنسبة لي باستثناء واحدة. بل في إحداها شاهدت لقطات من حفلة تخرج إحدى المدارس كان الأطفال (أقل من خمس سنوات) يرددون أناشيد الصحوة الجهادية على وقع أصوات الرصاص. كنت أظن أننا تجاوزنا هذه الحقبة!
4- بعض المدارس قالت لي بصراحة حين سألت عن تعليم الدين واللغة العربية؟ ” لا والله ما في إسلام ولا عربي”! مدرسة أخرى تريد فرض رسوم إضافية (3000-5000 آلاف) لساعة واحدة للغة العربية والدين في نهاية اليوم.
5- هناك بضع روضات نجحت – نظرياً على الأقل-في الموازنة بين توفير تعليم جيد وخاصة فيما يتعلق بتعليم اللغات والعلوم والتقنية، وفي الوقت نفسه لديها برامج قوية لتعليم اللغة العربية وتحفيظالقرآن الكريم إلى درجة مرضية جداً.
6- الفروقات بين المدارس كبيرة جداً، لجهة المباني، ومستوى التعليم، ومستوى وجنسية المعلمات، والنشاطات اللامنهجية، واستخدام التقنيات الحديثة، والنظافة، والرعاية، والاهتمام بالصحة والتغذية. ففي حين أخبرتني احدى المدارس أنها ستقوم ببيع الشكولاتة والبيبسي لصغيري بعد الظهر! أعطتني أخرى قائمة طويلة بالأطعمة الممنوع إرسالها في وجبة ابني، لدرجة لا تعرف معها ماذا سأصنع له غير شطيرة الجبنة!
7- تخلف هذه المدارس في نسبة عدد المعلمات والمربيات للأطفال، فعالمياً يجب أن تكون لهذه الفئة العمرية 1:4 وهو غير متوفر عندنا حتى في المدارس ذات الرسوم الفلكية.
8- أن هناك استغلالاً غير أخلاقي ولا منطقي للأهالي، فيقال لك مثلاً الرسوم 20 ألفاً في السنة، فتفكر بأن المبلغ مرتفع لكن توشك أن توافق مقابل الرعاية والمبنى الجميل والمزايا، ثم تفاجأ بأن المبلغ يشمل فقط الوقت ما بين الساعة 8-12.30 م، وهو وقت غير مناسب لجل الأمهات العاملات بسبب زحمة المواصلات على الأقل. وهنا يبدأ الابتزاز، إما زيادة 7000 (بحيث يبقون الطفل حتى الساعة الثالثة) أو لدى مدرسة آخر تدفع 150 ريال على كل ساعة زيادة، أو 2000 ريال في غيرهما وهكذا.
9- الرسوم لا تشمل الزي المدرسي (100 ريال وغالباً ستحتاج على الأقل إلى ثلاثة)، ولا المواصلات، ولا الواجبات (إن كانت المدرسة من النوع الذي يوفر وجبات)، ولا رحلات، ولا حفلة آخر السنة التي لسبب ما يجب أن تقام في قاعة أفراح وحبذا لو كانت قاعة “ليلتي!”، ولا بعض النشاطات الإضافية. ولا تشمل الكتب المدرسية، ولا رسوم التسجيل (تراوحت ما بين 1500-8000 ريال)، ولا الحفاضات والغيارات. وفي حالة الرغبة في خدمات إضافية (كتعليم الطفل استخدام الحمام أجلكم الله) فإن لها رسوماً إضافية. وبعض المدارس تشترط (من عمر 3 سنوات) مقابلات شخصية وامتحانات قبول، أسعارها ما بين (500-2500 ريال) غير مستردة، سواء تم قبول الطفل أو لم يتم قبوله.
10- بعض المدارس تديرها سيدات غربيات، خاصة المتزوجات من سعوديين، ولسن حاصلات على تصريح بمزاولة هذا النشاط، وذلك أمر متعمد لأنها كما تقول إحداهن صراحة:” لا أريد صداع السعودة”! وروضتها في مبنى بلا لوحة طبعاً، ومع ذلك مشهورة ومعروفة، وغالية جداً ولديها قوائم انتظار، ومضى على ممارستها لهذا النشاط حوالي ثمانية عشر عاماً!
ومع أنني كنت أعارض هذه الرسوم الغالية التي لا أجد مبرراً منطقياً لها، لكن عندما تعلق الأمر بصغيري، بدأت أفكر بشكل مختلف، خاصة وأنه في سن صغيرة جداً: ما هو أهم شيء أريد أن يتوفر لابني في عمر 2-5 سنوات؟
في الماضي كنت أظن بأن جوابي سيكون الأخلاق والدين الإسلامي واللغة العربية وبعدها النشاطات الممتعة الأخرى وأيضاً اللغة الإنجليزية. لكنني وجدت بأن جوابي اليوم: الأمان والثقة والرعاية. التأكد من أنه سيكون بخير، في مكان مناسب (شاهدت روضات فيها درج، وزوايا حادة، وتكييف عال، وبلاط عارٍ) مع مربية أو معلمة ليس فقط “تخلي عينها عليه” وإنما ترعاه بحب واهتمام. أن يكون لديها خبرة علمية وعملية في التعامل مع مرحلة الحضانة والروضة، وليست خادمة (ليس تقليلاً من هذه المهنة الشريفة) تم تكليفها برعاية الأطفال كما شاهدت في الكثير من المدارس. وأيضاً الموقع الجغرافي مهم جداً، فالتنقل في جدة في أوقات الذروة مرهق للجسد والأعصاب لنا نحن الكبار، فكيف للصغار المساكين؟ هذا عدا عن الخطورة والحوادث أجارنا الله وإياكم منها.
إنني أشعر بالخوف سلفاً من ترك طفلي في مكان غريب، وسأفعل ذلك لأنه ليست لدي خادمة أو مربية خاصة، ولأنني أعتقد بأن والدتي تستحق الراحة وليس مطاردة هذا العفريت الصغير ومغامراته البهلوانية، وأيضاً لأكسبه مهارات الاختلاط بالصغار واللعب الجماعي. ولذلك وجدت نفسي على وشك أن اتخذ قرارات صعبة، وعرفت بأن التنظير سهل لكن الواقع صعب. ووقع لومي أولاً على مقر عملي الذي لم يوفر لي – رغم وجود نظام يلزمهم بذلك-مكاناً آمناً ولائقا لطفلي، الذي حاولت إيجاد مكان له فيها منذ أن كنت حاملاً في الشهر الخامس ولم تكلل هذه العملية بالنجاح بعد.
لكن شيئاً ما لفت نظري في هذه الرحلة، بغض النظر عن الصراع النفسي-والقرار الذي لم يُحسم بعد-وهو أنني في موقع يخولني اتخاذ هذا القرار لكن غيري لا يملك خيار التعليم الأهلي من الأساس. هؤلاء ربما سيتجاوزون مرحلة ما قبل المدرسة بأكملها، وبالكاد يجدون لأطفالهم مكاناً في مدرسة ابتدائية حكومية. هذه المدرسة قد تكون مدرسة نموذجية في حي راقٍ في جدة أو الرياض، أو مدرسة استثنائية في الهيئة الملكية في الجبيل أو ينبع، لكن الغالبية منهم سيكون أبنائهم وبناتهم في مدارس عادية، في مبانٍ لا بأس بها على امتداد هذا الوطن الغالي. وفئة رابعة ستدرس في مدارس سيئة في مبان متهالكة وآيلة للسقوط في المدن، أو مدارس تفتقد أبسط الأساسيات في القرى.
جعلتني هذه المقارنة أشعر بشيء من تأنيب الضمير، مع أنني سأدفع لطفلي من حر مالنا، ولكن لإيماني بأهمية العدالة والمساواة الاجتماعية، ربما من التأثير الديني، وأيضاً لإقامتي الطويلة في بريطانيا، التي يُنظر فيها للتعليم الأجنبي بكثير من الريبة والنقد. نقطة شرائح عريضة من الشعب البريطاني فيما يخص معارضة السماح بالتعليم الخاص ما يلي:
1- أن التعليم في المدارس الحكومية يجب أن يكون راقياً ومتطوراً بحيث لا يفكر الأهالي بإدخال أبنائهم مدارس خاصة.
2- أن المدارس الخاصة تستطيع دفع رواتب أفضل، فتستقطب أفضل المعلمين الذين دربتهم الدولة في مدارسها العامة من أموال دافع الضرائب.
3- أن إعطاء تعليم أفضل لأبناء الأغنياء والميسورين يعني استمرار الحال على ما هو عليه مستقبلاً، بل وتوسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. فهؤلاء سيحصلون على درجات أعلى في امتحانات الثانوية العامة، وبالتالي يفوزون بأفضل المقاعد في أهم الجامعات، وستكون لديهم مهارات إضافية (إجادة لغات أجنبية مثلاً)، وبالتالي حينما يتخرج الجميع من الجامعة ويأتي وقت التوظيف، فإن هؤلاء سيكونون المرشحين الأبرز بين أقرانهم، لا لتفوقهم وذكائهم غير العاديين (وهذه عوامل مهمة ولا شك)، ولكن لأنهم منذ نعومة أظفارهم حصلوا على فرص لم يحصل عليها الآخرون.
وربما نختلف مع وجهة النظر المتشددة هذه تجاه التعليم الخاص، الذي كان موجوداً منذ الأزل، فلطالما حصل أبناء الملوك والأمراء والخلفاء وغيرهم على معلمين وتعليم مختلفين عن بقية الناس، ولكن يبدو أن كونهم أقلية الأقلية، جعل الأمر لا يشكل مشكلة وقتها، خاصة وأن هؤلاء في الغالب لا يحتاجون للعمل، ولن ينافسوا أحداً.
ولكن في نفس الوقت فإن وجهة النظر هذه جديرة بالاهتمام. فقد أجريت إحصائية سريعة لأبناء الأهل والأقارب والصديقات في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة. فوجدت بأن غالبية من يعيشون في العروس أبنائهم وبناتهم في مدارس إنترناشيونال وبالتالي باتوا على سبيل المثال يتحدثون الإنجليزية بطلاقة. بينما من يعيشون في المدنيتين المقدستين يكاد يكونون العكس. وبالإضافة إلى اللغة يتعلمون مهارات التواصل، والعرض التقديمي، والتعبير، والقراءة الحرة، والنقد، وغيرها من النشاطات البحثية والعلمية التي ربما لم ندرسها أو نعرفها آنذاك في بلادنا سوى في الجامعة. أتحدث تحديداً عن المدارس العالمية المتميزة والغالية وليس عن الكم الهائل من المدارس العالمية التجارية.
فتخيلت المشهد بعد عشرين سنة، حين يصبح عمر ابني – حفظه الله ورعاه- وأترابه 22 سنة، أي سن التخرج من الجامعة والتقديم على الوظائف، هل نتخيل بأن جاره (وليكن اسمه محمد) الذي درس في مدرسة حكومية مستأجرة، ولا يتقن الإنجليزية، والذي درس مناهج تقليدية بطريقة تقليدية جداً، يتقدم لوظيفة في شركة أرامكو – إذا كانت لازالت موجودة وقتها- سيستطيع التفوق على معن (الذي نفرض بأنه درس في مدرسة أهلية متميزة سواء كانت عربية تعلم الإنجليزية بشكل جيد، أو انترناشيونال تعلم العربية بشكل جيد) في المقابلة الشخصية –نظرياً- حتى لو تساويا في الدرجات ومستوى الذكاء؟
وحتى لو استطاع التفوق عليه، فأشك أنه سيتم توظيفه بدلاً من ابني، لأن من يجري المقابلة سيكون وقتها أقرب تعليماً وفكراً لتعليم أبناء المدارس الخاصة. إذا كانت الوظائف التي تعرض لجيلنا الذي كان يدرس حتى الجامعة باللغة العربية، كانت تشترط اللغة الإنجليزية فما بالك بالآن أو مستقبلاً؟ من يلوم الأهالي على الرغبة في الاستثمار في تعليم أبنائهم؟! الخوف من تكرار الإحباط الذي عانى منه بعض الآباء والأمهات يجعلهم يغضون الطرف عن أمور جوهرية مثل الهوية (الدين واللغة العربية والتاريخ والوطنية) مقابل الحصول على ما تم اخبارهم بأنه الشرط الأول للتوظيف.
لقد وصلنا إلى مرحلة لم يسبق أن كانت موجودة عندنا:
تعليم حكومي يوصف بأنه جامد وتقليدي وضعيف، ومدارس أهلية تأتي بأحدث المناهج الدولية والطرق غير التقليدية في التدريس والتعليم بالممارسة والترفيه.
مدارس تعتمد اللغة العربية بشكل كامل وكذلك التاريخ الهجري والجرعة الدينية فيها قوية والانجليزية ضعيفة، وأخرى تعتمد الإنجليزية بشكل كامل والتأريخ الميلادي في حين اللغة العربية والدين –إن وجدتا-فيهما ضعف مقارنة بالحكومية.
وعدد المنتسبين لهذه الأخيرة في تزايد، حتى خارج المدن الرئيسية، فهم لن يكونوا ” الأقلية المعزولة” والتي تتحرك في دوائر خاصة، ولها تجارتها وأعمالها الخاصة، كما الحال في دول العالم ومنها دول عربية كمصر، وإنما مع دخول أبناء الطبقة المتوسطة والمتوسطة الدنيا لهذه المدارس، فهذا يعني أن هؤلاء سيتنافسون على الوظائف الحكومية والخاصة، فكيف سيتواصل هؤلاء ويتفاعلون وهم حتى لا يعتمدون اللغة ذاتها؟
هل ستصبح العنصرية وقتها: تتكلم عربي أو انجليزي؟ (بمعنى الاتقان تحدثاً وقراءة وكتابة)
خريج حكومي أو أهلي؟
منهج بريطاني أو أمريكي؟
رسوم مدرستك ثلاثون ألفاً أو أقل أو أكثر؟
لسنا في دولة شيوعية، وطبيعي أن تكون هناك فروقات بين طبقات المجتمع المختلفة، وطبيعي جداً أن يحاول الأهل الواعون تقديم أفضل تعليم وتدريب وترفيه لأبنائهم، ولكن وجود هوة كبيرة تعليمياً بين أبناء المجتمع يمكن أن يتسبب بالكثير من المشكلات التي قد لا نشعر بها الآن لكنها ستكون بانتظارنا مستقبلاً، وما دمنا في صدد الحديث عن السعودية 2020 و2030 (بالمناسبة غريب اختيار التاريخ الميلادي لرؤية دولة تعتمد التاريخ الهجري بشكل رسمي!)، فربما من الأفضل لو بدأنا في محاولة تلافيها من الآن، أو على الأقل التقليل من آثارها.
ليست لدي عصا سحرية، والحلول ليست حاضرة في ذهني، ولكنني أعرف أمرين مهمين: أن التعليم الحكومي يظل هو الأصل لأنه متاح للجميع في كل قرية ومدنية، وبالتالي ينبغي أن نحرص جميعاً على تطويره ورفع مستواه، حتى لو اخترنا ادخال أولانا مدارس خاصة، لأن مستقبل البلد يعتمد عليه.
وأن من حق كل طفل أن يحصل على فرص تعليمية وتدريبية وتثقفية وترفيهية متساوية أو شبه متساوية مع أقرانه بغض النظر عن مكان إقامته أو مستوى والديه المادي والاجتماعي. وكلما قلت الفروقات بين طبقات المجتمع كلما كان ذلك أفضل لاستقرار المجتمعات وازدهارها، والدول الاسكندنافية خير مثال.
June 6, 2016
#هوية_الحجاز
لا نذيع سراً حين نتحدث عن العنصرية والتحزب في مجتمعنا، فهي موجودة ومحسوسة وتأتي في أشكال عدة، ولكنها في النهاية تصب في اتجاه واحد: التمييز التعسفي ضد الآخر. وقد يكون التمييز اجتماعياً فيُرفض على أساسه خاطب ما، أو مهنياً بحيث تلعب هذه الاعتبارات دوراً في الترشيحات والتعيينات والتقدم الوظيفي. ومع اتفاقنا على عدم خلو أي منطقة من العنصرية، إلا أن حدتها تختلف من منطقة إلى أخرى.
ولطالما عُرفت المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية أو منطقة الحجاز بأنها تسجل علامات جيدة في هذا المضمار، إذ كانت ولازالت بوتقة جميلة انصهرت فيها وتعايشت أعراق ومذاهب مختلفة من داخل وخارج الجزيرة العربية. وبالتالي لم يكن متوقعاً أن يثير مسلسل ذو طابع تاريخي – لم يعرض بعد – كل هذا اللغط ويُنتج عنه وسم بعنوان هوية الحجاز!
فالمسلسل الذي تنوي قناة mbc عرضه، واسمه “حارة الشيخ” هو المتسبب في إثارة هذه القضية، لأنه ظهر وكأنه يحتكر تمثيل تاريخ المنطقة وتراثها، ويحصر المنتمين لها في إطار معين، يمكن التعرف عليه من خلال اللهجة والأزياء. لكن ما غرد به السعوديون ممن أغضبهم “برومو” المسلسل، يشعرنا بأن هناك إحساساً دفيناً بالغبن، وجد فرصته للتعبير عن نفسه بسبب المسلسل. الذي للأمانة لم أفهم من دعاياته أنه يمثل الحجاز كلها، بل حارة متخيلة في مدينة جدة تحديداً.
من يقرأ ما كُتب في الوسم المذكور سابقاً سيتفاجأ لعدة أسباب. فهذه ربما المرة الأولى التي تكون المشكلة فيها بين مكونات المنطقة نفسها. تلك المكونات البشرية التي تعايشت مع بعضها في هذه البقعة الجغرافية منذ أن صدح الحق من جبال مكة العظيمة فساوى بين البشر وجعل ميزان المفاضلة التقوى. ومنذ أن بات سيدنا بلال مؤذن النبي، وهو الذي كان حتى الأمس عبداً حبشياً، ومنذ أن أعلن نبي الرحمة والهداية بأن سيدنا سلمان القادم من بلاد فارس في منزلة آل بيت النبوة، فيما النار والمسد لكفار بني هاشم ومنهم عم خاتم الأنبياء.
العبارات المكتوبة تشير إلى وجود خلل ما لم يأخذ حقه من الاهتمام. فلطالما اشتكى أهل الحجاز من إهمال تراثهم، وعدم صيانة آثار المنطقة كما يجب، وكيف أن بعض الأفكار الدخيلة التي رافقت فترات زمنية محددة قد غيرت الجميل من عاداتهم. لكن هذه المرة فإن واحداً من مكونات من هذا المجتمع نفسه، هو الذي يشتكي طمس عاداته وتاريخه وتراثه. مصدر الغرابة الأساسي هو أن أبناء الحجاز، يعرفون قبل غيرهم، بأن جل أهل المنطقة، حتى وإن كانت أصولهم من خارج الجزيرة العربية، أو من مناطق أخرى منها، إلا أن وجودهم قديم وسابق لتوحيد المملكة. كما أن تراثهم أصيل، وهو جزء من تراث المنطقة والبلاد ككل، فليسوا طارئين ولا مجنسين بالمعنى المتعارف عليه. فلماذا إذاً تطفو مثل هذه القضية الآن على السطح؟
في البداية سأتفق مع بعض هؤلاء بأن هناك لبساً في مفهوم الحجاز أو من هو الحجازي؟ فنجد أن البعض يقصره جغرافياً على مكة وجدة والمدينة، وأحياناً يتوسع ليشمل الطائف وينبع وكافة مدن وقرى الساحل الغربي. وقد يُستخدم لفظ الحجازي ليوصف به بالفعل حاضرة الحجاز فقط، ويستثنى منه أبناء القبائل العربية المنتمية لهذه المنطقة. ولعل هذا الاستخدام بالذات، والذي يقصر اسم المنطقة على فصيل دون آخر، هو ما تسبب في حالة عدم الرضا.
هناك أيضاً تهمة الاستلاب الثقافي، بمعنى بأن اللهجة الحجازية والطعام الحجازي والزي الحجازي، باتوا جميعاً يرمزون لفصيل واحد، خاصة عبر الإعلام، مما يجعل الآخرين يشعرون بأنهم دخلاء. والحقيقة أعجبني تفسير أحد المغردين الذي اعترف بأن ذلك قد يكون صحيحاً، خاصة لجهة التناول الإعلامي، ولكنه غير مقصود، ومرده أن الذين دخلوا المجال الفني والإعلامي منذ بداياته من أبناء المنطقة كانوا من الحاضرة مثل لطفي زيني ومحمد بخش ومحمد حمزة ووجنات الرهبني، فكان من الطبيعي أن يستخدم هؤلاء لهجتهم المميزة فصارت المنطقة تُعرف بها. لكن هذا لا يعني أنه لا توجد لهجات حجازية أخرى. وكل ذلك ثراء ثقافي، وتنوع طبيعي في مدن مليونية، ومدينة لندن على سبيل المثال فيها عدة لهجات، بحسب طبيعة عمل أهل كل منطقة. وها هي عاصمة الضباب تختار ابن مهاجر مسلم وصل بالأمس من باكستان عمدة لها. فالشعوب الناضجة لا تعيش في الماضي، وإنما تتطلع للمستقبل، وتبحث عمن يحقق متطلباتها.
الوسم الذي بدأ بغرض علمي كما قال أنصاره، وهو عرض المكونات الثقافية الأخرى لهذه المنطقة الغالية من بلادنا الحبيبة، والتي يرون أنها لم تأخذ نصيبها من الإعلام، تحول إلى وسم عنصري، يتراشق فيها أبناء بلد واحد ومنطقة واحدة التهم، ويمارسون ضد بعضهم تمييزاً عنصرياً بغيضاً لا يخدم المنطقة ولا تراثها المتنوع الجميل. لا أعرف لماذا يتصور البعض من الحضر أو أخوتهم أبناء القبائل أن وجوده لا يمكن أن يتحقق إلا بإقصاء الآخر؟ وأن لهجة واحدة أو ثقافة واحدة هي التي يجب أن تحمل لواء تمثيل منطقة عريقة ومتنوعة وثرية ومباركة مثل منطقة الحجاز؟
العنصرية لا تأتِ بخير، في أي صورة كانت، لأنها ترتكز على الإقصاء والتمييز، ولا تحقق المواطنة الكاملة للناس، ولأنها تفرق بينهم ليس وفق معايير الجد والاجتهاد في خدمة وطنهم، وإنما على أسس لم يخترها أحد منهم. فالوطني الحقيقي هو ذلك الذي يسعى لتقوية لحمة المجتمع، ونشر التآلف بين الناس، أما دعوات الفرقة فهي أشد خطراً من العدو الخارجي لأنها تنخر في المجتمع من الداخل، وهذه المكونات الحضرية والقبلية لأي منطقة باقية وستستمر وتتمدد، فلن يستطع أي مكّون اليوم إلغاء المكونات الأخرى، ومتى ما تقبل الجميع هذه الحقيقة وآمنوا بحتمية التعايش، سينشغلون بما هو أهم: بناء الوطن.
آنذاك لن يفلح ألف مسلسل، ولا مائة أغنية، ولا عشرة برامج حوارية، في أن يثيروا مشكلة أو يشعلوا فتنة.
د. مرام عبد الرحمن مكَّاوي
February 26, 2016
الهندسة الاجتماعية: فن اختراق العقول!
 كيف يمكن لشخص أن يقرِّر اقتحام شركة شحن، وينجح بطريقة سلمية وباستخدام الحدِّ الأدنى من المهارات التقنية؟ بدأ الأمر بإجراء بحث عن الشركة عبر الإنترنت، عرف اللص من خلاله رقم المسؤول عن الموارد البشرية. وبعد مكالمة هاتفية عرف منه أسماء الأشخاص الأهم في الشركة، وبعض أسماء الموظفين في أقسام معيَّنة، وأن أحد المديرين التنفيذيين في إجازة. وصل إلى مقر الشركة، وبلغة الواثق وبأسلوب لطيف وهو يحمل بطاقة عمل مزورة، ادَّعى نسيان مفتاحه. فسمح له الحارس بالدخول. وعند وصوله إلى الدور الذي يعمل فيه الموظفون ادَّعى نسيان بطاقات العمل تلك، الزملاء اللطفاء أدخلوه. وجد مكتب المدير المجاز غير مغلق لغرض التنظيف، فاتصل من تحويلة هذا المكتب بالقسم التقني، وقال لموظف لم يسبق له التعامل مع المدير إنه يواجه مشكلة في نسيان كلمة المرور، سرَّ الموظف الصغير لمساعدة المدير، وساعده في الحصول على كلمة سرٍّ جديدة، شكره المدير (المهاجم)، وقام بجمع ما يحتاجه من معلومات، قبل أن يغادر بكل هدوء ودون إثارة الريبة بعد تحقيق هدفه. مرحباً بكم في عالم الهندسة الاجتماعية!
كيف يمكن لشخص أن يقرِّر اقتحام شركة شحن، وينجح بطريقة سلمية وباستخدام الحدِّ الأدنى من المهارات التقنية؟ بدأ الأمر بإجراء بحث عن الشركة عبر الإنترنت، عرف اللص من خلاله رقم المسؤول عن الموارد البشرية. وبعد مكالمة هاتفية عرف منه أسماء الأشخاص الأهم في الشركة، وبعض أسماء الموظفين في أقسام معيَّنة، وأن أحد المديرين التنفيذيين في إجازة. وصل إلى مقر الشركة، وبلغة الواثق وبأسلوب لطيف وهو يحمل بطاقة عمل مزورة، ادَّعى نسيان مفتاحه. فسمح له الحارس بالدخول. وعند وصوله إلى الدور الذي يعمل فيه الموظفون ادَّعى نسيان بطاقات العمل تلك، الزملاء اللطفاء أدخلوه. وجد مكتب المدير المجاز غير مغلق لغرض التنظيف، فاتصل من تحويلة هذا المكتب بالقسم التقني، وقال لموظف لم يسبق له التعامل مع المدير إنه يواجه مشكلة في نسيان كلمة المرور، سرَّ الموظف الصغير لمساعدة المدير، وساعده في الحصول على كلمة سرٍّ جديدة، شكره المدير (المهاجم)، وقام بجمع ما يحتاجه من معلومات، قبل أن يغادر بكل هدوء ودون إثارة الريبة بعد تحقيق هدفه. مرحباً بكم في عالم الهندسة الاجتماعية!
الهندسة الاجتماعية.. ما هي؟
حين يأتي الحديث عن منظومة أمن المعلومات فإن أول ما يتبادر إلى أذهان كثيرين هي البرامج والأنظمة الإلكترونية الخاصة بها: برامج الحماية من الاختراق والفيروسات والجدران النارية وغيرها. متناسين أن العامل الأهم في أي منظومة أمنية، إلكترونية أو غيرها، هو العنصر البشري، وهو في الوقت نفسه العامل الأضعف فيها، إذ لا يمكن «برمجته» وضمان عدم ارتكابه للأخطاء.
 تقوم الهندسة الاجتماعية (Social Engineering) على مجموعة من التقنيات المستخدمة لجعل الناس يؤدون عملاً ما يفتح ثغرة أمنية أو يفضون بمعلومات سرية. وقد تستخدم في عمليات احتيال عبر الإنترنت أو على أرض الواقع، وتركز بشكل أساسي على مهاجمة الإنسان، واستغلال نقاط ضعفه للحصول على المعلومات المهمة، التي تمكن المهندس الاجتماعي (المهاجم) من اختراق المباني أو الأنظمة أو الحسابات لتحقيق منافع معنوية أو مادية أو أمنية. وذلك دون الحاجة إلى مهارات تقنية عالية كما هي الحال في «الهاكرز» و«الكراكرز» الذين غالباً ما يتميزون بمهارات برمجية ولديهم معرفة حاسوبية واسعة بالعتاد وأنظمة التشغيل والشبكات وثغراتها الأمنية المرتبطة بالتقنية. فما يحتاجه المهاجم هنا ليست المعرفة التقنية وإنما المهارات الاجتماعية (الذكاء الاجتماعي) ومهارات التسويق والإقناع لخداع الضحية بحيث يأخذ منها ما يريده دون إثارة الشبهات. بل إن حصوله على المعلومات في حدِّ ذاته بهذه الطريقة لا يُعدّ عملاً غير قانوني، إذ لا يوجد تشريع يمنع الأشخاص من إفشاء أسرارهم الشخصية (الأمر مختلف بالنسبة لأسرار العمل). والأهم من ذلك هو أنه لا يوجد تشريع ولا قانون يجرِّم الاستماع لشخص يختار أن يكشف لك عن معلوماته!.
تقوم الهندسة الاجتماعية (Social Engineering) على مجموعة من التقنيات المستخدمة لجعل الناس يؤدون عملاً ما يفتح ثغرة أمنية أو يفضون بمعلومات سرية. وقد تستخدم في عمليات احتيال عبر الإنترنت أو على أرض الواقع، وتركز بشكل أساسي على مهاجمة الإنسان، واستغلال نقاط ضعفه للحصول على المعلومات المهمة، التي تمكن المهندس الاجتماعي (المهاجم) من اختراق المباني أو الأنظمة أو الحسابات لتحقيق منافع معنوية أو مادية أو أمنية. وذلك دون الحاجة إلى مهارات تقنية عالية كما هي الحال في «الهاكرز» و«الكراكرز» الذين غالباً ما يتميزون بمهارات برمجية ولديهم معرفة حاسوبية واسعة بالعتاد وأنظمة التشغيل والشبكات وثغراتها الأمنية المرتبطة بالتقنية. فما يحتاجه المهاجم هنا ليست المعرفة التقنية وإنما المهارات الاجتماعية (الذكاء الاجتماعي) ومهارات التسويق والإقناع لخداع الضحية بحيث يأخذ منها ما يريده دون إثارة الشبهات. بل إن حصوله على المعلومات في حدِّ ذاته بهذه الطريقة لا يُعدّ عملاً غير قانوني، إذ لا يوجد تشريع يمنع الأشخاص من إفشاء أسرارهم الشخصية (الأمر مختلف بالنسبة لأسرار العمل). والأهم من ذلك هو أنه لا يوجد تشريع ولا قانون يجرِّم الاستماع لشخص يختار أن يكشف لك عن معلوماته!.
في أمريكا تقام في مدينة لاس فيغاس سنوياً مسابقة هدفها زيادة الوعي الأمني، يتبارى فيها الهاكرز ممن يعتمدون الأدوات التقنية فقط ومن يستخدمون الهندسة الاجتماعية، وذلك لاختراق الشركات أو المؤسسات الحكومية، ويعطى هؤلاء اسم الهدف قبل المسابقة بفترة وجيزة، لكنها كافية لجمع المعلومات الضرورية عنه. وتتم دعوة رؤساء هذه الشركات أو الأشخاص المسؤولين عن الأمن المعلوماتي فيها ليكونوا حاضرين وقت قيام الهاكرز باختراق دفاعاتهم أمام أعينهم وعن بُعد. ويلاحظ بأنه غالباً ما ينجح المهندس الاجتماعي في مهمته بشكل أسرع من التقني. ومن أشهر المهندسين الاجتماعيين: فرانك أباغنال، ودايفيد بانون، وبيتر فوستر، وخالد الفيومي.
 كيف تعمل؟
كيف تعمل؟
قد يستغرق اكتساب المهاجم الثقة المرجوة من الضحية ساعات أو أياماً أو أسابيع أو أشهراً متواصلة للتخطيط لهذه الهجمات، وفق درجة وعي الضحية وحساسية الهدف الذي يراد مهاجمته. وقد يتم ذلك بطرق عدة إما شخصياً وإما عن طريق الهاتف أو من خلال المواقع الإلكترونية.
يقول كيفن ميتنك وهو من أشهر المخترقين للأنظمة، الذي نجح ذات مرة في اختراق وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، وله كتاب شهير بعنوان فن الخداع (The Art of Deception): «إن اختراق العقول البشرية أسهل بكثير من اختراق الأنظمة الإلكترونية. فاللعب على نقاط ضعف الإنسان مثل رغباته وشهواته وحبه لمساعدة الآخرين، وميله إلى الظهور بمظهر العالم وصاحب السلطة أو المعرفة. ففلسفة الهندسة الاجتماعية تقوم على تجريدنا – ولبضع دقائق – من تفكيرنا المنطقي الحذر الذي نواجه به العالم فنحمي به أنفسنا وممتلكاتنا وأسرنا. وحين نكون متعبين أو حين يتم تشتيت انتباهنا عن طريق الإقناع أو التملق أو الإيحاء أو الدعابة أو التحفيز أو الإغراء وغيرها من المهارات الاجتماعية، فإن ذلك يمنعنا من رؤية المخاطر المحتملة.
أهم أساليبها
• الاحتيال عبر مكالمات هاتفية. وهكذا تتم النسبة الأعلى من هذه الهجمات، فيزعم المهندس الاجتماعي بأنه مندوب شركة ما تقوم بعمل استبيانات لأهداف بحثية، أو حتى مندوب حكومي يهدف إلى جمع الإحصاءات، أو مندوب مبيعات يحاول إقناع الضحية بشراء منتج ما عبر أسئلة تبدو ظاهرياً بريئة.
• الهندسة الاجتماعية المعاكسة وهي تستخدم الهاتف غالباً. والوضع هنا أخطر، إذ يدعي المهاجم بأنه شخص ذو منصب وصلاحية في المؤسسة نفسها، مما يجعل الموظف الأصغر مرتبة يرتبك ويخبره بما يريد. وإذا نجح الأمر وسارت الأمور كما خُطط لها، فقد يحصل المهاجم على فرصة أكبر للحصول على معلومات ذات قيمة كبيرة من الضحية. وهذا الأسلوب معقد نسبياً لكونه يعتمد على مدى التحضير المسبق وحجم المعلومات التي بحوزة المهاجم.
• استغلال المعلومات الموجودة في سلة المهملات في غرف التصوير أو الطباعة أو السكرتارية. والاحتيال في هذه الحالة قد يتمثل في الدخول إلى هذه المباني المحصنة، وذلك كما نشاهد في كثير من الأفلام عبر الادعاء بأنه عامل صيانة أو تنظيف. وإذا كان الهدف يستحق العناء، فقد يسعى المهاجم إلى الحصول على مثل هذه الوظائف بشكل رسمي بحيث تتاح له فرصة جمع المعلومات عن طريق البحث في سلة المهملات، أو عبر التنصت على المكالمات أو الاجتماعات دون إثارة أية شبهة.
• رسائل البريد الإلكتروني. تصل إلى الضحية رسالة تدعي الفوز بجائزة ما، أو تدعي أنها من جهة أهلية (البنك) أو حكومية، وتطلب إدخال البيانات بشكل مباشر، عبر صفحة تبدو للمستخدم العادي وكأنها غير مزورة. وتعرف هذه العملية بالتصيد (Phishing)، وتندرج تحتها أنواع مختلفة من الهجمات.
• الإنترنت بشكل عام. تشكل الشبكة العنكبوتية منجماً ضخماً للمعلومات، وقد تضاعف حجم هذا المنجم مع ظهور الشبكات الاجتماعية التي أسرف كثير من مستخدميها في عرض معلوماتهم الشخصية ومشاركتها مع الآخرين من خلالها، مما يسهل كثيراً عمل المهندس الاجتماعي. فحين يتصل بك شخص ويدعي أنه من طرف رئيسك أو أحد أفراد عائلتك، ويخبرك بأنه يعرف أنك تقضي حالياً إجازتك في تركيا مثلاً، ويذكر اسم أحد زملائك، ستثق به، وسيدور الحديث حول أمور تهتم بها كالرياضة والسياحة، ووسط هذه المحادثة ستنسى تحفظك الفطري، وتتخلى عن حذرك، فتصبح الفرصة مواتية للهجوم واستخراج المعلومات التي ما كنت لتدلي بها لو سئلت عنها بشكل مباشر من قبل غريب.
وهناك نوع من الهندسة الاجتماعية ليست ذات أهداف مادية ملموسة، ولكن الشخص قد يسعى للحصول على الحُب أو التعاطف اللذين يفتقدهما في حياته الواقعية عن طريق خداع الآخرين بأنه شخص آخر. فليس من الغريب وجود عدد كبير من الحسابات الوهمية على شبكات التواصل الاجتماعي التي يتستر خلفها أشخاص هدفهم إقامة علاقة مع الآخرين. تعرف هذه العملية بصيد القط (Catfishing). وفي الفِلم الوثائقي الذي يحمل الاسم نفسه (catfish) يقوم شيلمن وهو مصور فوتوغرافي بتوثيق قصة وقوعه في حُب فتاة ليكتشف لاحقاً بأنها شخصية وهمية، اخترعتها والدة الفتاة المزعومة لتهرب من واقعها الذي ترعى فيه طفلين معاقين إعاقة شديدة.
وللفن حضور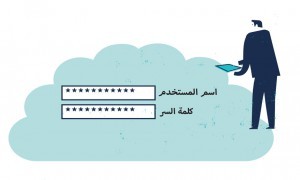 لم يكن الفن السابع بعيداً عن تناول هذا الموضوع المثير وتنبيه العالم لخطورته. نذكر هنا مثالين شهيرين. أولهما، فِلم «امسك بي إن استطعت» (!Catch me if you can) من بطولة ليونارديو ديكابريو، الذي يحكي قصة فرانك أباغنال، أحد أشهر المهندسين الاجتماعيين، الذي يبدأ كمراهق يهرب من منزله وينجح في ادعاء العمل كقبطان طائرة، ويجمع الأموال الطائلة من خلال هذا الدور ومن تنقله حول العالم، وينجح في التخفي من الشرطة كمعلم وطبيب، وبادعائه ممارسة هذه المهن الصعبة يخدع من حوله، قبل أن تتمكن الشرطة من الإيقاع به. والفِلم الثاني هو «قضية توماس كراون» The Thomas Crown Affair من بطولة بيرس بروسنن، الذي يلعب دور مليونير ملول فيقرِّر سرقة لوحة نادرة من متحف نيويورك، وكان قد بدأ التخطيط لعمليته عن طريق الحضور إلى المتحف بشكل يومي بحيث صار وجهاً مألوفاً للحراس والمسؤولين فيه، كما ينجح في جمع ما يحتاجه من المعلومات عن الأمن والحماية وغيرها عبر زياراته المتكررة، وبالتالي تنجح مهاراته في الهندسة الاجتماعية في تحقيق ما يريد.
لم يكن الفن السابع بعيداً عن تناول هذا الموضوع المثير وتنبيه العالم لخطورته. نذكر هنا مثالين شهيرين. أولهما، فِلم «امسك بي إن استطعت» (!Catch me if you can) من بطولة ليونارديو ديكابريو، الذي يحكي قصة فرانك أباغنال، أحد أشهر المهندسين الاجتماعيين، الذي يبدأ كمراهق يهرب من منزله وينجح في ادعاء العمل كقبطان طائرة، ويجمع الأموال الطائلة من خلال هذا الدور ومن تنقله حول العالم، وينجح في التخفي من الشرطة كمعلم وطبيب، وبادعائه ممارسة هذه المهن الصعبة يخدع من حوله، قبل أن تتمكن الشرطة من الإيقاع به. والفِلم الثاني هو «قضية توماس كراون» The Thomas Crown Affair من بطولة بيرس بروسنن، الذي يلعب دور مليونير ملول فيقرِّر سرقة لوحة نادرة من متحف نيويورك، وكان قد بدأ التخطيط لعمليته عن طريق الحضور إلى المتحف بشكل يومي بحيث صار وجهاً مألوفاً للحراس والمسؤولين فيه، كما ينجح في جمع ما يحتاجه من المعلومات عن الأمن والحماية وغيرها عبر زياراته المتكررة، وبالتالي تنجح مهاراته في الهندسة الاجتماعية في تحقيق ما يريد.
كيفية التصدي لها؟
تُعدّ الهندسة الاجتماعية من أكبر المشكلات التي تواجهها الشركات حالياً، لأنه ما من طريقة يمكن من خلالها اختبار وضمان عدم قيام الإنسان بارتكاب خطأ كما هو الحال مع البرمجيات وجدران الحماية. كما أن من المشكلات الكبرى في عالم الأمن الإلكتروني بشكل عام حالياً، كثرة تغير الموظفين في الشركة مقارنة بالسابق، فالحاجة المستمرة للدماء الشابة والمهارات الجديدة وللخبرات المتنوعة، لا سيما في المجالات التقنية، تجعل الناس ينتقلون من شركة إلى أخرى بسرعة كبيرة، وللشركة الواحدة عدة فروع قد لا يعرف أفرادها بعضهم بعضاً أبداً، أو يعرفون بعضهم فقط من خلال تواصل إلكتروني لا يصعب معه إخفاء الهويات. ولا تقوم كل الشركات بالتحري الدقيق عن الشخص المتقدم للوظيفة، وبالتالي لا يصعب أن يدخل المهاجم إلى قلب الشركة، وإلى مخزن البيانات الحساسة دون أن يثير أي ريبة، لأنه ببساطة موظف فيها! ففي حالات كثيرة تنجح الهجمات الإلكترونية بمساعدة شخص من داخل الشركة أو المؤسسة، إما عن طريق التعاون المباشر (عميل داخلي)، أو عن طريق الخطأ كما هو الحال في ضحايا الهندسة الاجتماعية.
ولذلك فإن أنجع طريقة لحماية المؤسسات والشركات، التي تكون صواريخ المهندس الاجتماعي موجهة إليها، هي في التوعية والتدريب. فتوعية الموظفين بالأساليب التي يمكن أن يستخدمها المهندس الاجتماعي لاستخراج المعلومات منهم، وتنبيههم إلى عدم إعطاء أي كلمة سرٍّ أو معلومة لأي شخص، مهما ادعى علو مرتبته في الشركة، إلا بعد التثبت بشكل عملي من هويته، وحثهم على الاقتصاد في تداول المعلومات الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي. ويمكن إجراء اختبارات دورية تشبه تلك التي تجرى باستمرار لاختبار متانة أجهزة الكشف عن الحرائق.
الأمر الآخر، حينما يتم توظيف أشخاص جدد سواء بشكل دائم أو بعقود مؤقتة أو عبر شركة ثالثة، فلا بدَّ من السؤال والتقصي عن الشخص بشكل دقيق، لضمان خلو تاريخه مما يثير الريبة.
وهذا لا يعني بأنه ستكون هناك حصانة تامة. فحين يتعلق الأمر بأمن المعلومات، سيظل المجرمون يبتكرون طرقاً جديدة للاختراق، وسيظل الطرف الآخر، يحاول استباق هجماتهم بالتحصين، فالعلاقة بينهما طردية. لكن الوقاية تبقى دائماً خير من العلاج.
التميز..مرحلة أم رحلة؟
 يحرص جل الآباء على تعليم أطفالهم في أفضل المدارس، وأحياناً يزيدون على ذلك بإحضار معلمين خصوصيين في المنزل، وإلى تسجيلهم في الدورات التعليمية والثقافية رغبة منهم في إكسابهم أكبر قدر ممكن من القدرات واللغات. والهدف أن يساعدهم ذلك في بناء مستقبل مشرق لأنفسهم حين يشبون فيجدون مقاعداً في أحسن الكليات بأفضل الجامعات، ومن ثم يحصلون بعد ذلك على عمل ممتاز. وفي سبيل تحقيق ذلك يدفعون الأموال الطائلة، بل وقد يعمل هؤلاء الآباء والأمهات في عدة وظائف، وقد يغتربون عن بلدانهم، للعلم والعمل، في سبيل توفير معيشة راقية لهؤلاء الأبناء. فهل ما يقومون به من جهد مقدر ومشكور كفيلٌ بضمان تحقيق هذه الأهداف؟
يحرص جل الآباء على تعليم أطفالهم في أفضل المدارس، وأحياناً يزيدون على ذلك بإحضار معلمين خصوصيين في المنزل، وإلى تسجيلهم في الدورات التعليمية والثقافية رغبة منهم في إكسابهم أكبر قدر ممكن من القدرات واللغات. والهدف أن يساعدهم ذلك في بناء مستقبل مشرق لأنفسهم حين يشبون فيجدون مقاعداً في أحسن الكليات بأفضل الجامعات، ومن ثم يحصلون بعد ذلك على عمل ممتاز. وفي سبيل تحقيق ذلك يدفعون الأموال الطائلة، بل وقد يعمل هؤلاء الآباء والأمهات في عدة وظائف، وقد يغتربون عن بلدانهم، للعلم والعمل، في سبيل توفير معيشة راقية لهؤلاء الأبناء. فهل ما يقومون به من جهد مقدر ومشكور كفيلٌ بضمان تحقيق هذه الأهداف؟
الواقع يقول بأنه يستحيل التيقن من الوصول للأهداف المرجوة من قبل الوالدين. إذ هناك التوفيق من الله أولاً، وأيضا قدرات ورغبات الأبناء في النجاح. فحين أخذت جولة ذهنية استحضرت فيها صديقات الطفولة وكيف كن وصرن اليوم تفاجأت بالنتائج قليلاً. فصحيح أن هناك من كانت متفوقة في طفولتها وحتى هذا اليوم، ومن كانت متعثرة في دراستها منذ البداية وحتى اليوم، وهنا لا يكون الأمر مستغرباً، لكن العكس صحيح كذلك.
فعدد من الطالبات المجتهدات، وممن تمتعن برعاية عائلية غير عادية، انتهى بهن الأمر في كليات ووظائف عادية، بل وعدد منهن لم تكمل تعليمها الجامعي، أو توقفت عنده فلم تكمل دراسات عليا أو حتى تتوظف. وبالمقابل فنسبة أخرى ممن كن طالبات عاديات ودون رعاية أسرية خارجه عن المألوف، تميزن فقط في آخر سنة في الثانوية وأصبحن اليوم استشاريات في الطب، أو تميزن في المرحلة الجامعية وواصلن حتى الحصول على الدكتوراه.
وكما ذكرت من يتميز في الدراسة ثم يتراجع، وهناك من يتميز في بدايات العمل في العشرينات والثلاثينات حتى يُعتبر نجماً صاعداً لكن ما أن يصل الأربعين حتى نجد بأنه توقف في نقطة ما لم ولن يتجاوزها على ما يبدو. وهناك من بعكسه سواء في العمل أو القيادة أو الفن يبزغ نجمه متأخراً لكنه يكتسح مجاله بشكل لم يستطع أحد التنبؤ به. فما الذي يجعل المرء متميزاً في مرحلة عمرية ما ومتراجعاً في مرحلة أخرى؟ هل أن الجهد الذي يبذله المرء في أول عمره يجعله يحترق مبكراً والعكس صحيح؟ هل يساهم الملل أو الغرور أو الإسراف في الإطراء، في تراجع المتميز بينما غيابهما عن الإنسان العادي يكون دافعاً له ليصنع من نفسه شيئاً متميزاً؟
ربما ليست هناك إجابة واحدة صحيحة، لكن ما يمكن الخروج به هنا هو كيف يمكن أن يؤثر ما ذُكر على حياتك. فإذا كنت ممن رزقك الله ببداية طيبة في الحياة من رعاية وتعليم وتفوق فعليك أن لا تركن إلى تميزك السابق أو الحالي، حتى لا تُفاجئ بأن الزمن قد تجاوزك، فالعمل المستمر على تطوير الذات ومواكبة التغييرات أمر لا بد منه. أما إذا كنت شخصاً عادياً وتتمنى أن تخرج من هذا الإطار وتغدو ناجحاً متميزاً ومختلفاً، فعليك أن تدرك بأن الوقت لم يفت ما دمت على قيد الحياة، والعبرة بالخواتيم، فكل ما تحتاجه عزيمة وعمل لصناعة بداية جديدة.
January 11, 2016
عودة للمتع البسيطة
 عندما كنا أطفالاً كانت متعتنا تتحقق ببضعة ألعاب حصلنا عليها بالعيدية أو بعد إحضار الشهادة، ومشاهدة برامج الرسوم المتحركة خاصة المدبلجة منها، واللعب في فناءالمنزل للبنات وربما الشارع للأولاد، وفي عطلة نهاية الأسبوع اللعب على الشاطئ في المدن الساحلية وفي البر في المدن الداخلية، ومع ذلك كانت تلك المتع تشعرنا بالسعادة، ولم نكن نشكو الملل بالطريقة التي يشكو منها الجميع هذه الأيام.
عندما كنا أطفالاً كانت متعتنا تتحقق ببضعة ألعاب حصلنا عليها بالعيدية أو بعد إحضار الشهادة، ومشاهدة برامج الرسوم المتحركة خاصة المدبلجة منها، واللعب في فناءالمنزل للبنات وربما الشارع للأولاد، وفي عطلة نهاية الأسبوع اللعب على الشاطئ في المدن الساحلية وفي البر في المدن الداخلية، ومع ذلك كانت تلك المتع تشعرنا بالسعادة، ولم نكن نشكو الملل بالطريقة التي يشكو منها الجميع هذه الأيام.
تعريفنا للمتعة كان يومها بسيطاً: أن نشعر بالسعادة وأن نضحك ونمرح، لم يكن لها سعر ولا مواصفات ولا شروط، ولذلك كان الحصول عليها ممكناً وسهلاً ومتساوياً للجميع تقريباً. لكن شيئاً فشيئاً تغير الوضع، وبدأت المتعة تحتاج إلى ميزانية تزداد ضخامة عاماً بعد آخر. وباتت تعني للكبار عشاءاً فاخراً في مطعم، أو السفر لدولة قريبة أو بعيدة، أو استئجار شاليهات بأسعار فلكية، أو الاحتفال بمناسبة بسيطة في فندق خمس نجوم. وللصغار صار يعني شراء المزيد من الأجهزة الإلكترونية والألعاب الباهظة، وزيارة مدن الملاهي والترفيه.
كلنا تقريباً وقعنا أسرى لهذا التصور المكلف عن المتعة والفرح، ومع زيادة انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، ازداد الوضع سوءاً لأنه تحول في أحيان كثيرة إلى استعراض وتنافس فيما بيننا لإظهار مقدار السعادة والمتعة التي نشعر بها، فعبر النصوص والصورة ومقاطع الفيديو، بات المرء يشارك مع الآخرين كل ما يقوم به تقريباً، من المشتريات إلى أطباق الغداء في أحدث سلسة مطاعم في المدينة إلى آخر رحلة سياحية، وآخر مفاجأة عائلية، وبالطبع فإن كل ما يعرض تقريباً يجب أن يكون غالياً ومميزاً ويثير رغبة الآخرين في التقليد. حتى الأطفال باتت صورهم تحوي قدراً أقل من البراءة وقدراً أكبر من الاصطناع الذي يطلبه منهم ذويهم، وصارت جل صورهم وكأنها مأخوذة في ستديو تصوير وليس في صالة منزلهم!
الغريب أنه وسط كل هذه البهرجة لم تختف الشكوى من الملل، بل كما روت لي إحدى الأمهات أن ابنها لم يتوقف عن الشكوى من الملل حتى وهو في جنة الصغار ديزني ورولد! فقد ارتوينا حتى لم يعد هناك ما يكفينا، وما عاد شيء يسعدنا أو يبهرنا أو يسلينا.
البعض أزعجه ذلك وقرر أن يبحث عن بديل، وأخذ ينوع في خياراته، ومنها العودة إلى المتع القديمة: نصب خيمة في البر، أو فرش سجادة في فناء المنزل لشرب الشاي أو القهوة في الأجواء الشتوية الجميلة، أو اللعب بالكرة مع الصغار، أو أخذهم للسباحة على شاطئ البحر. والنتيجة؟ أن اليوم ينتهي مع إحساس بحقيقي الرضا والراحة إن لم يكن بالسعادة والفرح.
فنحن من نعطي للأشياء قيمتها وللحظات معانيها، فتجمع الأسرة معاً فعلياً، وليس عبر الأجهزة المحمولة أو أثناء الانشغال بها، هو لوحده حدث سعيد.
فالسعادة الحقيقية – لحسن الحظ-ليست مرتبطة بالمال، وليست حكراً على الأغنياء دون الفقراء، فكل ما يدخل البهجة على قلوبنا من المتع الصغيرة يغمرنا بها فتصبح أيامنا سعيدة وحياتنا أكثر جمالاً.
مرام عبد الرحمن مكاوي's Blog
- مرام عبد الرحمن مكاوي's profile
- 36 followers









