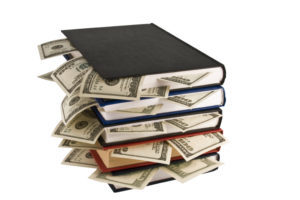مرام عبد الرحمن مكاوي's Blog, page 6
November 25, 2016
اليوم التالي لسقوط الولاية
أتابع على “تويتر” الوسم الخاص بإسقاط الولاية، ومع أنني كنت من المشككات فيه ابتداء، وبالرغم من عدم مشاركتي فيه لقناعات خاصة، إلا أنه أثار اهتمامي لعدة أسباب. فلأول مرة تكون هناك حملة شعبية نسائية لا تقودها شخصية بعينها قد تكون تسعى للشهرة والاستعراض وصناعة المجد الشخصي، متخذة من حقوق المرأة السعودية ذريعة. فالتغريدات صادرة عن نساء عاديات ومن مختلف الطبقات، بينهن المنقبة والمحجبة والسافرة. وهذه الحملة السلمية التوعوية صامدة لما يزيد على ثلاثة أشهر، رغم تهم التخوين والتشكيك والشتائم والقذف في الدين والعرض للمشاركات فيها. وهذه المطالبات لا ترتكز على العاطفة، بل تحاول إثبات أحقية المطالبات بذكر قصص واقعية موثقة بالأدلة ومنشورة على صفحات صحفنا المحلية، توضح كيف أن بعض القوانين والتنظيمات الإدارية تتسبب في تعقيد حياة المرأة وتكبيلها إن كان الولي ظالما.
الكاتبات السعوديات منذ أن سمح لأقلامهن بأن ترى النور على صدر صحافتنا وإعلامنا كن يكتبن مطالبهن بخجل ابتداء، ثم أصبحن أكثر صراحة، لكن التركيز كان على الجزئيات، على الفروع وليس الأصول، كالمطالبة بحق العمل والتعليم والزواج (أو عدمه للقاصرات أو المجبرات)، وقيادة المرأة للسيارة والرياضة والسفر. وأكثرهن شجاعة طالبت بمعاملة المرأة كفرد مستقل، وكمواطن على قدم المساواة مع شقيقها الرجل. لم تكن من بينهن -فيما أعلم- من طالبت صراحة بإسقاط الولاية. فالولاية خط أحمر ولا يجب أن تمس، ومجرد التفكير في الاقتراب من الحمى كفيل بأن يصيب أصحاب الصوت العالي باللعنات والتهم المعلبة هذه الكاتبة، وقد يمارس “الاحتساب” ضدها فتمنع من الكتابة. أما النساء في هذه الحملة فقد بدأن من حيث انتهين وليس من حيث توقفن. فذهبن إلى أصل المشكلة وبيت الداء، وهي هذه السلطة المطلقة أو شبه المطلقة لأولياء الأمور على النساء. فمن كان وليها رجلا محترما واعيا واثقا من نفسه ويخاف ربه فستعيش في الغالب عيشة طيبة تحقق فيها أحلامها. وإن كان سوى ذلك فستجد نفسها في ضنك مع من يحصي عليها أنفاسها، ويتحكم فيما تأكل وما تشرب وما تلبس وما حتى تفكر به. لذلك كانت مطالبتهن واضحة: إسقاط الولاية عن المرأة عند بلوغها سن الرشد مثلها مثل شقيقها، فثارت ثائرة البعض ممن كانوا بالأصل يعارضون أي مطالبات فردية تحاول تحصيل بعض الحقوق للمرأة. وهنا يبرز السؤال: لماذا يخشون إسقاط الولاية؟
حاولت أن أتبين إجابة عشوائية عبر استفتاء بسيط في تويتر فكانت أغلب الإجابات تتركز حول الخوف من أن يستخدم للتغرير بالفتيات، والحقيقة أن مجتمعنا غريب، فهو يعتقد أن المرأة جاهزة وناضجة بما يكفي لتتزوج وهي دون العشرين، بل هي في سن الطفولة أو بدايات المراهقة، وأنها واعية كفاية لاتخاذ هذا القرار المصيري، في حين لو افترضنا أن سن الرشد هو 21 عاما، وهو السن الذي يُسمح فيه في كثير من الدول للشباب بالتصويت وتقرير مصير الدول، فهي ستكون معرضة للتغرير! وقد يكون هذا الأمر منطبقا على بعض النساء، لكن هل هو ذريعة لمعاقبة البقية؟
لقد تعرض عدد لا يستهان به من شبابنا للتغرير من قبل المنظمات الإرهابية العالمية منذ أكثر من عشرين سنة، وزج بهم في حروب ليست حروبهم، ومع ذلك لم نسمع بأحد طالب، كوسيلة لمحاربة الإرهاب والحفاظ على شبابنا، برفع سن الرشد للشباب حتى الثلاثين! لأنه لو حصل ذلك لما استطاع الشباب الدراسة ولا العمل ولا حتى الزواج، وسيؤدي ذلك إلى تكبيل المجتمع.
البعض يتخيل أنه بمجرد إسقاط الولاية التي هي غير القوامة التي جعلها الله حقا للرجل على زوجته فقط، والتي هي غير المحرم الذي اشترطته الشريعة للسفر والحج، والتي ذكرت في القرآن في سياق المحافظة على القاصر واليتيم والسفيه عقلا، وفي السنة في سياق زواج البكر، مع أن الأحناف لهم قول في وجوب اشتراط الولي، ولهم أدلتهم المعتبرة، فإنه لن تبقى امرأة في بيت أبيها ولا زوجة على ذمة زوجها. عندما فكرت بشكل شخصي، كيف ستتغير حياتي فيما لو تم تغيير القوانين والتنظيمات الإدارية وإسقاط هذه الولاية الأبدية على المرأة السعودية، فوجدت أنه لن يتغير شيء مطلقا! قد يكون التغيير الوحيد هو قيادة السيارة فيما لو سُمح بذلك.
أما الذكر المتسلط، الذي يعلم بأنه يحرم النساء اللاتي هن تحت ولايته من حقوقهن، ويسيء استخدام هذه السلطات، فمن الطبيعي أن يشعر بالقلق والخوف، مثله مثل الحاكم الديكتاتور الذي يخشى الديمقراطية لأنه لا يثق بشعبه. فسلطاته ستتقلص أو تختفي، وهو الذي لا تتحقق رجولته المتوهمة إلا بالترهيب والتسلط.
بصراحة الكثير من النساء المتضررات لن يسعين إلى تخريب بيوتهن بأنفسهن بمجرد إسقاط الولاية كتنظيم إداري في المملكة، فالمرأة لا تفكر في نفسها فقط، بل تحمل هم والديها وأطفالها وأسرتها ككل. ما زلت أذكر زميلة من أصول شرقية أيام دراستي في بريطانيا، كانت تعاني من تسلط إخوتها، مع أنها كانت طالبة دكتوراه، وهم من الطبقة العاملة، ولم يكونوا يسهمون في مصروفات المنزل، وكانوا يمنعونها حتى من الحجاب فقط من باب فرض السيطرة. فكنت أسألها: لماذا تتحملينهم؟ لماذا لا تستقلين عنهم؟ لماذا لا تشتكينهم للشرطة عندما يمارسون العنف؟ أنتِ بريطانية الولادة والنشأة، ألم تتعلمي في هذا البلد كيف تدافعي عن حقوقك؟! وكان يأتيني جوابها: من أجل ذكرى أبي.. وحتى لا أرى دموع أمي! إنهم أولادها، وهي تحبهم وللأسف أفسدتهم، ولكن فات الأوان للتغيير. ومع أنني قد لا أتفق مع تصرفها، إلا أنني أدركت وقتها أن وجود القوانين الداعمة للمرأة لا يعني أن المرأة ستستخدمها بالفعل، فلكل حساباتها وظروفها، وهي “اختارت” أن تصبر.
الله وضعنا على هذه الأرض، وأرسل لنا الرسل لبيان الحق، ومنحنا العقل لنقرر ونختار في أي طريق نسير، ولو كانت المرأة ضعيفة العقل وقليلة الإدراك ولا تستطيع اتخاذ قراراتها بنفسها، لما كان الله العادل قد كلفها بما كلف به الرجل، وحاسبها كما يحاسب الرجل، لا سيما في الحدود. فمنح المرأة حقوقها ومعاملتها كإنسان كامل الأهلية لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بل يأتي متوافقا معها ومتسقا مع مقاصدها العليا.
November 18, 2016
هل تكفر أمريكا بالديمقراطية التي أتت بترامب؟
تابع العالم باهتمام كبير نتائج الانتخابات الأميركية الأخيرة، والتي انتهت بفوز مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب على مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، نحو غير متوقع من قبل جل المحللين ومعظم وسائل الإعلام الأميركية والعالمية. فقد مني الحزب بهزيمتين كبيرتين عامي 2008 و2012، رغم أن المرشحين في السباق الرئاسي آنذاك: جون ماكين وميت رومني، كانا يتمتعان بشعبية عالية داخل الحزب وخارجه، ولم تحط بهما المشكلات التي أحاطت بترامب، وهو القادم بالأصل من خارج الحزب وخارج حلقة السياسيين في واشنطن. كما أن هيلاري، زوجة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، ووزيرة الخارجية في عهد الرئيس بارك أوباما، كانت أول امرأة تترشح لهذا المنصب، وتوشك أن تصنع بذلك سابقة يخلدها التاريخ الأميركي، مستندة على خبرتها السياسية الطويلة وعلاقاتها وعلاقات زوجها المتشعبة والقوية. لكن هذا ما حصل في النهاية: فاز الملياردير المثير للجدل برئاسة أقوى دولة، فكيف تصرف الخصم المهزوم؟
في حين كان العالم ما زال يحاول استيعاب صدمة فوز ترامب، الذي أخاف نصف شعوب العالم خلال حملته الانتخابية ليكسب أصوات الناخبين، خرجت هيلاري كلينتون في أول خطاب لها بعد إعلان النتيجة لتشكر مناصريها، وتعترف بالهزيمة، التي سمتها مؤلمة، ولتقول شيئا مهما، يوضح لنا لماذا أميركا دولة عظمى. قالت: “دونالد ترامب هو رئيسنا الآن، ونحن مدنيون له بأن نمنحه عقلا منفتحا والفرصة ليقودنا”. هكذا إذاً، الاعتراف بنتائج العملية الديمقراطية، والتسليم بأن خصمها بات قائد البلاد الأول، وأن من حقه أن يُمنح “فرصة”. وطبعا هذه الفرصة مدتها أربع سنوات، هي مدة فترته الرئاسية، فإن لم يستفد منها، سيُستبدل بمن يعتقد الشعب أنه الأفضل وقتها.
هيلاري كلينتون التي قد لا نتفق مع الكثير من أفكارها وسياساتها في الشرق الأوسط، لم تعترض على نتائج الانتخابات، ولم تتهم أحدا بالتزوير، ولم تخرج لتحذر الشعب من الحكم “الترامبوي” الذي سيدمر البلاد، والذي لا بد من التدخل لإنقاذ الوطن منه. ومع أن المظاهرات، عمت بعض المدن الأميركية، اعتراضا على فوز ترامب، إلا أن الجيش الأميركي القوي لم يتدخل من تلقاء نفسه، لم نسمع له صوتا، لم يجهز عدته ليضرب هؤلاء الشباب، أو ليناصرهم، أو يطلب تفويضهم لمنع وصول ترامب للبيت الأبيض. فمهمة ضبط الأمن الداخلي وحفظ النظام العام والتعامل مع مثل هذه الأحداث هي مسؤولية الشرطة. وظيفة الجيش تكمن في تلقي الأوامر من القيادة المنتخبة، وحماية البلاد من العدوان الخارجي، وتحقيق مصالحها العليا، وسلاحهم لن يكون ضد الشعب الأميركي الذي ينتمي إليه. لهذا السبب، أعلم أن أميركا -رغم فوز ترامب- ستكون بخير، وستواصل تحقيق أفضل النتائج في مجالات الطب والرياضة والعلوم والتقنية والترفيه والثقافة، فنهضتها المادية إنما هي انعكاس لنظامها السياسي رغم كل العيوب التي فيه. وبمقارنة الحالة الأميركية بالحالات العربية في الدول الجمهورية، يتضح لنا الفارق الهائل حضاريا وثقافيا على مستوى النُخب قبل الأفراد.
أدهشتني في الحقيقة تعليقات بعض الكتاب المثقفين العرب على نتائج فوز دونالد ترامب، إذ أخذوها ذريعة “للتشمت” بالديمقراطية، والتي هي في الأخير منتج بشري، يعاني الكثير من السلبيات والنواقص الهائلة بالفعل، لكنه في الوقت نفسه ساعد الكثير من المجتمعات على تحقيق الحد الأدنى من ضرورات الحياة للمواطنين، كالحرية والعدالة والشفافية، وذلك عبر التداول السلمي للسلطة ومحاربة الفساد وحفظ المال العام.
هؤلاء المثقفون أخذوا يرددون أن الديمقراطية قد تأتي بأي كان للحكم! والحقيقة أن ندرك الآن أن ترامب أرادنا ربما أن نعتقد أنه مهرج، لأن ذلك كان يخدم أهدافه وحملته الانتخابية ويحقق له الانتشار الذي يريده، لكنه أثبت في النهاية أنه أبعد ما يكون عن ذلك، فهو رجل أعمال ناجح جدا لا يعرف الفشل، وله علاقاته الواسعة، وها هو قد صار الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة!
وحتى إذا افترضنا جدلا أنه يتصف بالأوصاف التي قيلت عنه، فإن الشعب الأميركي مضطر لتحمله لمدة 4 سنوات فقط. فالمرأة الأميركية التي وضعت طفلها ليلة فوزه يمكنها التخلص منه -عبر صناديق الاقتراع- في انتخابات 2020 قبل أن يدخل مولودها هذا المدرسة. في حين اضطر الشعب الليبي على سبيل المثال أن يتحمل العقيد معمر القذافي 40 سنة دون أن يختاره، ودون أن يستطيع التخلص منه. وحينما حلت ساعة الخلاص أخير في 2011 فإن ذلك كان على حساب ليبيا الدولة والأرض والشعب والثروات، فثمن التغيير كان غاليا جدا، وتوشك 6 سنوات أن تمر على قتل الرئيس الليبي دون أن تتعافى طرابلس بعد.
الأمر الثاني، إذا سلمنا بأن الديمقراطية يمكن أن تأتي بأي كان، فإن من أهم مميزاتها أنها لا تمنح الحاكم المنتخب حكما مطلقا، بل هناك مؤسسات لها سياساتها ذات سقف وتحكمها أطر وخطوط عريضة، ولا يمكن لأي رئيس مهما بلغ من قوة وكاريزما وشعبية وذكاء أن يتجاوزها. فهؤلاء يدركون المقولة الشهيرة: “السلطة المطلقة.. مفسدة مطلقة”. ترامب لن يحكم منفردا، فهناك مجلس الشيوخ ومجلس النواب والمحكمة العليا، وكل هؤلاء يعملون مثل “الكوابح” توقف شطحات أي مغامر أو مقامر. فباستطاعتهم لو أرادوا تعطيل جل برامج الرئيس، وذلك كان واضحا إبان حكم أوباما، الذي عانى كثيراً في تمرير قراراته حتى أصيبت إدارته بما يشبه الشلل.
قد يقول قائل إن كل ما تم ذكره في هذه المقالة يؤكد حقيقة بأن بعض الشعوب لا تصلح لها الديمقراطية، أو أن بعض الأمم غير جاهزة للتعددية والمشاركة الشعبية، والأمثلة حولنا حيثما يممنا وجهنا عن شرقنا وغربنا. لهؤلاء نقول بأن الشعوب الأميركية والأوروبية واليابانية وغيرها لم تولد وهي جاهزة، ولا تتمتع بجينات تجعلها أفضل وأجدر بإدارة شؤون بلادها، وإنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. وكذلك الانتخاب، فهو ممارسة شعبية تبدأ من المدرسة وتُبنى عبر سنوات داخل الإنسان حتى يشب عوده، ويستطيع أن يميز بين من يعتقد أنه يفيد بلده أو يضره، بعيدا عما تريده الروابط الأسرية والالتزامات القبلية والاعتبارات الطائفية والدينية والمناطقية، فالأوطان باقية والبشر ماضون.
أن تكون مواطنا صالحا
لطالما اعتقدتُ أن ثمة مفهومين تعرضا في بلاد العرب منذ سنوات طوال إلى التشويه، وهما: التدين والوطنية. فقد باتا يعنيان لدى البعض ألا تسأل ولا تناقش ولا تعترض، ولا يكون لك -باختصار-رأي في أي شيء. وأنا لا أقصد هنا أن يكون للشخص رأي في كلام الله -عز وجل-أو كلام رسوله -صلى الله عليه وسلم-وإنما رأي في آراء وكلام وقرارات البشر من العلماء والفقهاء والدعاة والحكام ومن يدخل في حكمهم. فمهما بلغوا من حكمة ودهاء وعلم وبصيرة يظلون بشراً يصيبون ويخطئون. بل إن الصحابة أنفسهم -رضوان الله عليهم- كان يراجعون النبي المعصوم في أمور الدنيا، وكان عليه الصلاة والسلام يشاورهم ويأخذ برأيهم، كما حصل في غزوة الخندق مع سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه. لكن يبدو أن حالة الانحطاط التي يمر بها العالم الإسلامي منذ بضعة قرون أسهمت في تشويه الكثير من المعاني. فالمسلم الذي يسأل عن صحة بعض الأحكام الفقهية التي لم يرد بشأنها نص صريح، ويجادل في إمكانية أن يكون هناك حكم آخر؛ قد يوصف بالنفاق أو الزندقة! والأمر مشابه على ما يبدو في مسألة الوطنية، فكون المواطن ليس متحمساً لبعض القرارات الإدارية، أو مطالبته ببعض التعديلات أو الإصلاحات، خاصة التي تمس رزقه ومعيشته، تجعله يوصم من قبل بعض المزايدين بأنه جاحد أو حتى خائن لوطنه!
قبل أيام تم إيداع الرواتب بعد التعديلات الجديدة، ففي الخامس من برج “العقرب” عرف كل موظف حكومي مقدار الحسم في الراتب الجديد، والذي تراوح ما بين بضعة مئات لدى البعض وبضعة آلاف عند البعض الآخر. ومن الطبيعي ألا يكون الشعور واحداً لاختلاف الرواتب، والمكانة الاجتماعية، والتكاليف المعيشية، والالتزامات المادية. فهل كل من عبر عن ضيقه أو أبدى أسفه عبر وسائل التواصل الإلكترونية ليلتها مواطن سيئ لا يقدر ظروف وطنه؟!
والأمر نفسه يتكرر بعد تصريح وزير المالية حول وضع اللمسات الأخيرة على قانون الضريبة المضافة على السلع، والتي يتوقع أن تبلغ 5% من قيمة السلعة. بمعنى إذا كنت تشتري سلعة قيمتها 100 ريال في السابق فأنت ستدفع حينما يتم تطبيق هذا النظام 105 ريالات، وهكذا. وبالرغم من أن هذه الضريبة ستستثني المواد الغذائية والصحة والتعليم والخدمات المجتمعية، إلا أن المواطن يخشاها لأسباب عديدة، منها أن أسعار السلع في أحيان كثيرة أغلى من مثيلاتها في دول الجوار، وبالتالي سترتفع الأسعار أكثر، والإعلان عنها جاء في وقت حسم البدلات والعلاوات، والكثيرون لم يضبطوا مصروفاتهم بعد وفق الواقع الجديد، فمجرد التفكير بأن هناك المزيد من التكاليف المادية يشعرهم بالقلق.
آخرون ينظرون إلى الموضوع من ناحية شرعية، على اعتبار أن الإسلام أباح الزكاة وحددها بالتفصيل في المال والدواب وخراج الأرض، بحيث يتحقق بها التكافل الاجتماعي، فتؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، وتتكفل الدولة الإسلامية بجبايتها من الناس وتوزيعها عليهم كذلك. فيما حرم في الوقت نفسه المكوس (الضرائب). وكان القادة المسلمون عند فتح البلدان يقومون برفع المكوس الظالمة التي وضعها الروم والفرس، واستبدالها بالزكاة للمسلم والجزية لغير المسلم، وكل هذه أمور معروفة في التاريخ الإسلامي وموثقة. فهل من يذكرها اليوم، أو يبين السلبيات المحتملة اقتصاديا واجتماعيا عند تطبيق الضريبة المضافة، يعتبر محرضاً أو شاقاً لعصا الجماعة؟
بالتأكيد أن الجواب هو لا، حتى وإن حاولت بعض الأقلام الإيحاء أو التصريح بذلك. فهذا الحراك المجتمعي على صعيد النقاش والحوار وطرح الأسئلة وكتابة المقالات وإعداد المقابلات الإذاعية والتلفزيونية، يحصل في كل مكان تقريباً على هذه الكرة الأرضية. فالعالم يمر بحالة تشبه الكساد الاقتصادي، وبلدان عدة تعاني من صعوبات مالية جمة، وسياسات الترشيد والتقشف باتت واقعاً يعيشه الناس. وبغض النظر عن درجة متانة الاقتصاد، واختلاف الأنظمة، فإن الحكومات ستظل تردد أنها مضطرة لاتخاذ إجراءات اقتصادية تدرك أنها بلا شعبية، وتظل الشعوب في الطرف المقابل تحاول أن تغير أو تقلل من تأثير هذه الإجراءات على المواطن العادي.
الفرق بين العرب وغيرهم هو أن العربي يُتهم بالأنانية وقلة الوطنية، وقد يصل الأمر إلى تجريمه أو تخوينه إن هو عبر عن رأيه، بينما في المجتمعات الديمقراطية، فإن تعبيره عن رأيه يعد ممارسة طبيعية لحقوقه المدنية. بل إن تعريف المواطنة الإيجابية في هذه البلدان يذكر بأن من واجبات المواطن الصالح التبليغ عن الفساد وهدر المال العام، ومراقبة أداء الحكومة، والتأكد من التزامها بدستور البلاد وأنظمة الدولة وقوانينها.
فماذا يجب أن يكون تعريف المواطنة الصالحة عربياً وإسلامياً؟
ابتداء هي ضد الخيانة، فلا تنشر الفتنة، ولا ترفع السلاح، ولا تبيع أسرار الدولة للأعداء، ولا تتواصل أو تعين أي أطراف خارجية أو داخلية ضد مصالح وطنك، تحت أي ذريعة، وألا تشذ عن الجماعة وتخرج على ولي الأمر. فأمن الأوطان وسلامتها واستقرارها وحماية ثرواتها وحدودها وأهلها خطوط حمراء لا يجب أن تمس.
ولكن المطالبة بالإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لا تعتبر شكلا من أشكال الفتنة والخيانة، إذا كان هدفها الارتقاء بالأوطان، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتعايش الإيجابي بين المواطنين، فهما من أقوى خطوط دفاع أي مجتمع. فالعدو آنذاك لن يجد منفذاً مفتوحاً يلج منه خلسة، أو جرحاً ناتئاً يبث فيروساته عبره.
أن تكون مواطناً صالحاً يعني أن تسعى لتطوير نفسك بالتعليم والتدريب، وأن تكون نافعاً لمجتمعك، بالإخلاص في العمل، وبعدم هدر الموارد الوطنية، وبالمحافظة على البيئة، وبالمساهمة في السلم الاجتماعي بعدم التعدي أو ممارسة التمييز ضد الناس، وبعدم أخذ ما ليس لك مستنداً على ما بين يديك من سلطات وصلاحيات. ويعني أن تتطوع لخدمة مجتمعك إن استطعت بلا مقابل. وإن كنت مسلماً، فإن من حق وطنك عليك أن تدعو له كذلك بكل خير وصلاح.
لكن الوطنية الحقة لا تعني أبداً أن تتحول إلى كائن صامت، لا يحاور ولا يناقش وليس له رأي في أي تغيير حوله، فذلك وضع المواطن الميت -رحمه الله- والموتى لا يبنون الأوطان.
October 26, 2016
اقتطع من راتبي لكن لا تسفه ما أفني فيه عمري
 رب كلمة قالت لصاحبها دعني! لا أظن أن هناك مناسبة تصح فيها هذه المقولة أكثر من المقابلة الأخيرة “المسجلة” للأستاذ داوود الشريان مع وكيل وزارة التخطيط ووزيري المالية والخدمة المدنية في برنامج الثامنة الأسبوع الماضي. وإن كان مجمل ما قيل فيها محبطاً، فإن الجملة الشهيرة لوزير الخدمة المدنية خالد العرج بأن “إنتاجية الموظف السعودي في اليوم لا تزيد عن ساعة” تظل الأكثر إثارة للصدمة والإحباط للآلاف من الموظفين الحكوميين، الذين تمنوا لو استطاعوا أن يسألوا معالي الوزير عن تفاصيل تلك الدراسة التي استقى منها معلوماته، وأن يعطوه لمحة عما يقومون به كل يوم. كما يود الكثير منهم سؤاله، باعتباره موظفاً حكومياً سعودياً، عما إذا كانت هذه الدراسة تنطبق عليه كذلك؟
رب كلمة قالت لصاحبها دعني! لا أظن أن هناك مناسبة تصح فيها هذه المقولة أكثر من المقابلة الأخيرة “المسجلة” للأستاذ داوود الشريان مع وكيل وزارة التخطيط ووزيري المالية والخدمة المدنية في برنامج الثامنة الأسبوع الماضي. وإن كان مجمل ما قيل فيها محبطاً، فإن الجملة الشهيرة لوزير الخدمة المدنية خالد العرج بأن “إنتاجية الموظف السعودي في اليوم لا تزيد عن ساعة” تظل الأكثر إثارة للصدمة والإحباط للآلاف من الموظفين الحكوميين، الذين تمنوا لو استطاعوا أن يسألوا معالي الوزير عن تفاصيل تلك الدراسة التي استقى منها معلوماته، وأن يعطوه لمحة عما يقومون به كل يوم. كما يود الكثير منهم سؤاله، باعتباره موظفاً حكومياً سعودياً، عما إذا كانت هذه الدراسة تنطبق عليه كذلك؟
أكتب مقالي هذا من مكتبي في جامعة المؤسس، والذي داومت فيه يوم “السبت” تطوعاً، وذلك للإشراف على طالباتنا المشاركات في مسابقة عالمية للبرمجة (IEEE Extreme Programming 2016). فإذا كان عملنا التطوعي يزيد عن ثلاث ساعات، فكيف بعملنا الأساسي؟ هل يعرف معاليه أن محاضرة واحدة مدتها تزيد عن الساعة، والتحضير لها أكثر من ساعة، وتصحيح الواجبات والاختبارات لشعبة تزيد عن الثلاثين طالبة تأخذ 6-8 ساعات، ووضع أسئلة امتحانات ومراجعتها وطباعتها قد تستغرق ثلاثة أيام إلى أسبوع؟ إضافة إلى الاجتماعات والأعمال الإدارية، والإشراف على الرسائل العلمية. وهو فوق ذلك مطالب بحضور الدورات التطويرية ونشر الأبحاث العلمية وإلا لن تعرف الترقية بابها إليه.
لقد تحدث معاليه باستنكار عن بدلات الندرة والحاسب وغيرها للأكاديميين، وسماها إعانة، وهذه التسمية لوحدها إهانة. فالإعانة تكون مساعدة للمريض أو للمحتاج، أما ما يؤخذ مقابل العمل، فيمكنك أن تسميه راتباً أو بدلاً، لكنه حتماً لا يدخل تحت باب الصدقة.
وقد نتفق في أن مسميات بعض هذه البدلات مضحكة، وتوحي ببند غير مستحق، وربما حصلت فيها تلاعبات، ولكنها تأتي لتسد الخلل في الراتب الأساسي الضعيف لأعضاء هيئة التدريس. ولو سألت كثيراً من الأكاديميين والعسكريين وكافة موظفي القطاع الحكومي، لقالوا إنهم لا يمانعون حسم كل هذه البدلات، مقابل تعديل سلم الرواتب الأساسي، الذي لا يتناسب مع تكاليف المعيشة الغالية في المملكة. فهذه الرواتب حتى من قبل خصم البدلات لم تكن تسمح للمواطن الحكومي، المعتمد على الله تعالى ثم على راتبه فقط، بامتلاك شيء أساسي وهو بيت العمر بدون قروض البنك وأقساطها المجحفة.
وإذا كنت قد تحدثت عن الأكاديميين باعتباري واحدة منهم، فإنني أدرك أن هناك من موظفي القطاع الحكومي من يعملون مثلنا أو أكثر، فالمعلمات يداومن من السابعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، ولو أنهن كن لا يعملن أكثر من ساعة، فمن الذي يدرس بناتنا إذاً؟ هذا إذا افترضنا أنهن يعملن في المدن، أما إن كن في القرى المنسية، فالمعلمة قد تستغرق ثلاث ساعات حتى تصل إلى قريتها، ومثلها عند العودة، ناهيك عن الوقت الذي تقضية في أداء مهمتها التعليمية. كنت أعرف معلمة كانت تداوم يومياً من جدة إلى الطائف ذهاباً وعودة! هل من العدل القول بأنهن لا يعملن إلا ساعة؟
وبعيداً عن السلك التعليمي، فهناك الأطباء والممرضون والمسعفون والعاملون في القطاع الصحي، ورجال الإطفاء والدفاع المدني والشرطة والعسكريون وموظفو الجوازات وغيرهم، فلو أن كل هؤلاء كانوا فعلاً يعملون لساعة واحدة فقط لانهارت الدولة. فحين لا يوجد من يدرس أو يعالج أو يطفئ الحريق أو يحمي الوطن، فكيف تكون هناك دولة أو يقوم مجتمع؟!
هل كل هؤلاء مخلصون في أعمالهم وملتزمون بواجباتهم؟ بالطبع لا! ففي كل مهنة يوجد المتميز والمستهتر، من يقبل بأن يأكل أولاده من مال حرام لم يتعب فيه، ومن يتصبب عرقاً لأجل لقمة العيش الشريفة، لا فرق في ذلك بين وزير ولا خفير. وكلنا شاهدنا ونشاهد نماذج من هؤلاء الموظفين المهملين ممن يعطلون مصالح الناس، وكلنا نتمنى وجود نظام قوي يمنعهم من اعتبار الإفطار الجماعي ولعب الورق جزءاً من العمل في الدوائر الحكومية. لكن ما أزعج الغالبية من كلام الوزير هو أنه عمم ولم يستثنِ، وأشعرنا بأننا كُسالى، وطفيليون نقتات ظلماً على موارد الدولة، مع أنها – بالأصل- موارد الناس.
الأمهات بشكل خاص انزعجن بشكل أكبر من تصريحاته، لأن الأم عندما تخرج للعمل، تترك خلفها رضيعاً معتمدا على صدرها، أو فطيماً محتاجاً لها، فهي لم تتركه مع أهلها أو خادمتها أو حتى في حضانة مرتفعة التكاليف لتستمتع بوقتها في مكان العمل. هي خرجت إما لتحقق ذاتها وتنفع نفسها، أو لأنها المعيل الوحيد لأسرتها، أو لأن راتبها مع راتب زوجها بالكاد يكفي لمصاريف الحياة.
يبدو أن كلام الوزير كان تصريحاً من العيار الثقيل تم إطلاقه دون احتساب ردة الفعل، فقد تجاوز المحلية وقفز إلى صدر عناوين الصحف الدولية: “السعوديون الكُسالى على وشك الإفلاس” كما في عنوان صحيفة التايمز البريطانية (Lazy Saudis are on brink of bankruptcy). ويالنا من شعب محظوظ فعلاً! فحتى الأمس كان الإعلام الغربي يصفنا بالإرهاب وظلم المرأة، والآن صارت لدينا صفة جديدة وهي الكسل، لا شك أن هذا سيسهل من حصول طلابنا على خطابات في أرقى الجامعات، وعلى دفع المستثمر الأجنبي على اختيار بلادنا كوجهة أولى لصرف أمواله.
قبل شهر علمنا بموضوع حسم البدلات وشكل ذلك مفاجأة كبيرة، إلا أننا تقبلنا الأمر واعتبرناه إجراء لا مفر منه للصالح العام. لكن ما لا نتقبله هو أن يتم استقطاعه بحجة أخرى، وهي أننا أصلاً لم نكن مستحقين له، أي أننا نعاقب على تقصيرنا وإهمالنا وضعف إنتاجيتنا! مما يشي بأن هذه البدلات قد ذهبت للأبد، وأن الراتب لن يعود كما كان، لا بعد سنة ولا عدة سنوات. ففي التصريح نسف لكافة جهودنا وتعبنا وإخلاصنا في أعمالنا. فلسان حالنا: اقتطع ما شئت من راتبي.. لكن لا تسفه ما أفني فيه عمري.
October 12, 2016
تحولات اقتصادية تنتظر تغيرات اجتماعية
المتغيرات الاقتصادية الأخيرة كثيرة، منها ما هو عالمي، كانخفاض أسعار النفط، ومنها ما هو محلي وإقليمي. وقد نتج عنها محليا سياسات ترشيد طالت الكثير من الأسر السعودية التي يعمل أربابها في القطاع الحكومي، حيث الرواتب في بعض الجهات الحكومية ترتكز على البدلات بشكل رئيس. ومع إلغائها وجدت الكثير من الأسر نفسها في مأزق، خاصة الذين تورطوا في قروض بنكية بالاعتماد على إجمالي الراتب القديم. وإن كان موظف القطاع الحكومي هو المتضرر المباشر، فإن موظف القطاع الخاص سيلحقه الضرر عاجلا أو آجلا، فحين تنحسر الأموال في أيدي الناس، ستقل قدرتهم الشرائية والاستهلاكية، وستنخفض مدخولات الشركات وما تقدمه بالتالي لموظفيها. فكيف يواجه المجتمع السعودي اليوم هذه التحولات الاقتصادية الصعبة؟
سيطرت الصدمة على المشهد أول الأمر، وكان طبيعيا أن يبدأ الكثيرون بالتبرم، وهو أمر يحصل مع كل تغيير اقتصادي ورفع للدعم أو فرض للضرائب في أي دولة، فأخذوا في التحسر على المبلغ المقتطع من رواتبهم، الذي تتناوشه أصلا جهات عدة ما بين شركات الاتصالات والمياه والكهرباء، وتكاليف الاستقدام ورواتب الخادمات والسائقين. وهنا انبرى بعض “غير المتضررين” لإعطاء هؤلاء البعض محاضرات في الوطنية وإنكار الذات، وهم لو نقص من راتبهم مئة ريال لتضجروا، فكيف يلومون موظفا فقد ثلث أو نصف راتبه فجأة؟!
وكعادة البشر يمرون بالصدمة ثم الإنكار ثم العودة لتقبل الواقع، وهنا بدأ فريق آخر يقترح طرقا جديدة للتعايش مع الراتب بعد خفضه، وهذه الطرق جميعها تركزت على ما يجب أن يقوم به المواطن حتى لا “يبعزق” مدخوله الشهري على كماليات مثل شرب القهوة يوميا من محلات الكوفي شوب! ويطالبونه مثلا باستبدال الملاهي المدفوعة بالحدائق العامة، وإخراج الأبناء من المدارس الخاصة، بالإضافة إلى عدم السفر، والاكتفاء بحفلة زواج واحدة.
ومن المفيد فعلا أن يراجع المرء بشكل دوري حساباته، فيقلل من المصروفات غير الضرورية، ويوجه مدخوله فيما يفيده وأسرته على المدى الطويل، لكن يفترض حينئذ أن تكون كل قراراته في الإنفاق اختيارية، أما حين يقف أمام بعض هذه الخيارات، فهنا تصعب عملية المراجعة، لأن القرار في النهاية ليس بيده. وأقرب مثال هو موضوع المواصلات بالنسبة للمرأة، سواء كانت عاملة أو غير عاملة، مع كونه ضرورة حتمية للمرأة العاملة أو الطالبة، وضرورة حياتية لغيرهما.
فنظرا لكون القيادة محظورة على المرأة السعودية، فهذا يعني أنها حين تجلس لتخطط لكيفية إنفاق راتبها الجديد، فلن تستطيع أن تفكر في كيفية تقليص المصروفات في بند المواصلات. فإذا كان لديها سائق، فإنها لا تملك أن تقلص لا راتب السائق، ولا إيجار غرفته، ولا تكاليف استقدامه أو تجديد إقامته. أضف إلى ذلك أقساط السيارة وتكاليف البنزين والصيانة وكافة المستلزمات التي تدخل تحت هذا البند. فتشعر حينها بأنها في وضع محرج، لأن هذه المصروفات مفروضة عليها، وإلا لو سُمح لها بقيادة سيارتها لوفرت على الأقل 3000 ريال شهريا. والأمر نفسه ينطبق على رب الأسرة، الذي لا يتمكن بسبب عمله والتزاماته من القيام بواجباته في إيصال أفراد أسرته جميعا إلى مدارسهم وجامعاتهم وأعمالهم، فيضطر إلى إحضار سائق، قد لا يحتاجه فيما لو استطاع تقاسم هذه الأعباء مع زوجته.
لم تعد قيادة السيارة ترفا، فإذا كانت الموظفة الحكومية كمعيدة الجامعة مثلا تقتطع ربع أو ثلث راتبها في السابق لتكاليف المواصلات، فهي الآن ربما تدفع نصفه بلا مبرر حقيقي، إلا أن “المجتمع” لا يتقبل فكرة أن تُصّرف أمورها بنفسها. ولكن هذا المجتمع “الكريم” لن يقوم بدفع هذه التكاليف، وإنما سيكتفي بالتنظير وإلقاء الخطب والمواعظ التي تتبنى الدفاع عن الفضيلة!
وما ينطبق على قيادة المرأة، ينطبق على عملها، فالخطب عن كونها درة مصونة وجوهرة مكنونة، كانت بلا سند منطقي أو شرعي، وهي اليوم أكثر سخفا. فالدعوة لأن تكون المرأة درة مصونة لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي، وهي حقيقة يجب أن ندركها ونتكيف معها ونتخذها فرصة بانتظار التغيرات المنتظرة. فسنوات الرخاء جميلة إلا أنها ربما أسهمت بشكل كبير في تأخر صدور الكثير من القرارات الحيوية التي تمنح المرأة استقلاليتها. فقد كان هناك رأي يعتقد بأن خروج المرأة للعمل هو للتسلية فقط، ولتنافس الرجل -وذلك بالمناسبة من حقها تماما- ولذلك يتم تعقيد الأمر لها حتى لا تعمل، سواء عن طريق تقليص فرص العمل المتاحة لها، أو اشتراطات موافقة ولي الأمر، أو عدم توفير المواصلات.
اليوم تغير كل ذلك، فالكثير من الأسر كانت لا تستطيع العيش براتب واحد قبل خصم البدلات، أما بعد خصمها فبات الاعتماد على راتب الأب الذي انخفض ربعه أو ثلثه شبه مستحيل، خاصة لجهة الصرف على الخادمة والسائق، ولكن تظل الخادمة “اختيارا” من قبل المقتدرين، أما السائق فهو “فرض” ما لم يتم رفض الحظر عن القيادة.
يقول المختصون في السياسة والاقتصاد إن التحولات الاقتصادية حتمية، وسياسة الترشيد ضرورية، وبالتالي فإن إحداث تغييرات اجتماعية مصاحبة لها بات مطلبا جوهريا. لا لأن تلك مطالب النخبة الليبرالية المنفصلة عن واقع الناس، كما يردد المعارضون في أدبياتهم، ولكن لأن ذلك يأتي في سياق تلبية احتياجات الطبقة المتوسطة، التي تمثل سواد الشعب. هذه الطبقة المهددة في ظل هذه الظروف الاقتصادية، ووسط جمود في الحالة الاجتماعية، وهو جمود لا يتناسب مع تغير الأحوال والأزمان.
من يضبط بوصلة التعليم الأهلي
شاركني القراء الكرام وبعض المغردين على موقع تويتر، مشكورين، بتجاربهم على وسم #دراسة_أم_تجارة. 
وبالرغم من أننا تناولنا موضوع الرسوم المرتفعة، إلا أنه يظل الموضوع الأكثر إزعاجاً للأهالي، خاصة مع الظروف الاقتصادية الحالية. الدكتور منصور المالكي من جامعة الطائف غرد قائلاً: “المزعج في الأمر أنه لا يوجد هناك أي ضابط لموضوع تحديد الرسوم، ووزارة التعليم يقع على عاتقها عدم ضبط هذه الفوضى المتراكمة”! مغردة أخرى ذكرت أن طريقة تعامل بعض المدارس غير لائقة، ففي أول العام، إما أن تدفع 50% من الرسوم وإلا لن يدخل الطالب الفصل، دون اعتبارات لأي ظروف طارئة ودون نظام تقسيط عادل. إحدى الأمهات علقت بأن المبنى هو المبنى، والمعلمون لم يتغيروا ولا المناهج ولا الطلاب، ومع ذلك هناك زيادة سنوية بمقدار ألفي ريال في مدرسة ابنها.
وإذا انتقلنا من الرسوم الفلكية إلى نقاط أخرى، نجد أن فتح المجال للمدارس العالمية في تدريس مناهج مختلفة عن المناهج السعودية، قد جعل بعض هذه المدارس حرة في “اختراع” مناهجها الخاصة، التي هي في الحقيقة “تجميع” لمناهج من دول مختلفة، وُضعت لطالب مختلف في بيئة مختلفة، ويدرسها معلم متمكن ضمن منهج شامل ومتكامل، فلا ينتج عن استيرادها للطالب السعودي أو العربي سوى التشتت. فتكون النتيجة طالبا لا يتقن لا العربية ولا الإنجليزية، ولا يفقه لا أمور الدنيا ولا الدين. وتشتكي بعض الأمهات من كون الطلبة مثلاً، لا يتمكنون من إنهاء نصف الدروس من الكتاب الفاخر الذي أجبر الأهالي على شرائه بمبالغ مرتفعة. وأخبرتني زميلة عادت قبل عام من أميركا، وتدرس ابنتها في مدرسة عالمية، بأن المنهج قد يكون هو نفسه المنهج الأميركي الذي كانت تدرسه ابنتها هناك، ولكن شتان بين طريقة التدريس ما بين جدة وتكساس: فهناك يتم “تعليمه” للطالبة، وهنا “تحفيظه” لها! ويبدو أن الحفظ سيظل دوماً وأبداً لازمة من لوازم التعليم في الدول العربية.
أيضاً بوصلة الدين غير منضبطة في بعضها. فإحدى المدارس تشعر بأنه بالرغم من أنها عالمية إلا أنه يسيطر عليها فكر أقرب للفكر المتشدد حتى لمراحل الطفولة المبكرة، وفي المقابل أخبرتني أم بأنها سحبت ابنتها من مدرسة أخرى لا تسمح للطلبة بترك الصف للصلاة، لعدم وجود فسحة صلاة، إلا بطلب رسمي من ولي الأمر! وهنا لا بد من وقفة، فللدولة الحق ليس فقط في فرض نفوذها على المدارس المرخصة تحت إشراف وزارة التعليم، بل حتى تلك التابعة لسفارات بعض الدول، ما دام يدرس فيها سعوديون، خاصة في دروس التاريخ والجغرافيا، حيث قد يتسلل الدعم الغربي إلى وجود الدولة العبرية من خلالها، أو حتى عبر قصة “بريئة” للأطفال. ولنتذكر كيف تدخلت السلطات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرهما فيما يتعلق بالأكاديميات السعودية ومناهجها والحملات الإعلامية التي شُنت عليها.
وهذا إذا كنا نتحدث عن مدارس مرخصة وتعمل في النور، فهناك لاسيما في مرحلة رياض الأطفال، العديد من الحضانات والروضات التي لا يشرف عليها أحد! وليس على أبوابها لوحة تدل عليها، وتدار غالباً من قبل سيدات غربيات متزوجات بمواطنين أو من قبل مقيمات في المجمعات السكنية للأجانب “الكمباوندز”. وتتميز هذه المدارس برسومها العالية، وبعدم خضوعها لأي جهة رقابية، وبالتالي لا يمكن التأكد من اشتراطات السلامة والصحة والنظافة فيها، ولا معرفة ماذا يُدرس من خلالها، ولا كيف يتم التعامل مع الأطفال هناك. والعجيب أنها ناجحة جداً، ولديها قوائم انتظار، وبعضها يعمل بدون ترخيص منذ ما يقارب العقدين! فيبدو أن كون المديرة أوروبية أو أميركية أو كندية، حتى لو كانت وظيفتها الأساسية في بلدها نادلة في مطعم، يعني أنها مؤهلة لرعاية الأطفال في هذه السن الصغيرة والمهمة. أو أن الأهالي لقلة المعروض، وبعد المسافات ومشكلة المواصلات، قرروا الرضا بما هو موجود. إحدى المديرات تخبرك صراحة بأنها لا تريد تسجيل مدرستها بشكل رسمي، حتى لا يزعجها أحد بأمر السعودة.
هناك جانب آخر ربما لم يتم التطرق إليه في السابق، ولكن ذكرت لنا دكتورة في الجامعة بأنها بدأت تواجه مشكلة مع الطالبات الجدد في مادتها، فقد صار الصف منقسماً إلى نوعين: المتخرجات في المدارس العالمية، وزميلاتهن خريجات المدارس الحكومية والأهلية العربية. هاتان المجموعتان غير متجانستين، لا من ناحية اللغة التي يتقنها كل فريق، ولا من ناحية الخلفية المعرفية. فالمناهج العلمية في الجامعات السعودية وضعت في سياق تكميلي للمناهج التي يتم تدريسها في مراحل التعليم العام السعودي، والتي تختلف عن تلك التي يتم تدريسها في المدارس العالمية. فتصبح الدكتورة في حيرة، إذ كيف تقدم مادتها العلمية دون أن تظلم أحداً؟! فما يبدو صعباً لهؤلاء هو العكس بالنسبة للفريق الآخر. ونحن لا نتكلم عن الفروقات الفردية الاعتيادية بين الطلبة، وإنما عن اختلاف رئيسي بين ما تلقته كل مجموعة قبل المرحلة الجامعية. فما دام كلا التعليمين العام والعالي هما الآن تحت مظلة واحدة، فكيف سيتم التعامل مع هذا التحدي الجديد؟
موضوع المدارس الخاصة والعالمية له إذاً جوانب متعددة، قد يكون أبرزها الجانب الاقتصادي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، والتي قد تجعل بعض الأهالي عاجزين عن دفع رسوم النصف الثاني من السنة، لكن هناك جوانب أخرى دينية وثقافية وتعليمية وصحية وأمنية. وفي الوقت الراهن فإن البوصلة على ما يبدو لا تشير إلى الشمال الحقيقي، وهو أمرٌ يحتاج تدخلاً حازماً. ولقد أخذني وقتٌ لأقتنع بأن وجود خيارات تعليمية متنوعة هو أمر إيجابي، ويثري الخارطة العلمية في المملكة، وينتج جيلاً بمعارف متنوعة، بل ومن حق الأهالي اختيار ما يناسبهم ويناسب أولادهم، ولكن ما لا يصح هو ترك الحبل على الغارب، فتنتج هذه السلبيات التي قد تجعل العملية برمتها أكثر ضرراً منها نفعاً.
دراسة أم تجارة؟
الأبوة وكذلك الأمومة مسؤولية كبيرة. ومن أهم الأمور التي أيقنتها حينما أصبحت أُمّا هي أن كثيرا منها ربما كنت أنتقدُ الآخرين عليها قد تكون صحيحة ومنطقية نظريا، لكن على أرض الواقع حينما يوضع الأب أو الأم فعليا في هذا الموقف، تصبح مجرد كلام في الهواء غير قابل للتطبيق.
واحدة من هذه الآراء، كانت فيما يختص بإلحاق الأبناء بالمدارس الأهلية، خاصة العالمية، ودفع رسومها الفلكية، وهو أمر كنت أعتبره ترفا، لا يجدر بغير المقتدر أن يخوض فيه، ثم يشتكي ارتفاع الرسوم الباهظة. فالمدارس الحكومية متوافرة بالمجان في كل مدينة وحي وقرية وهجرة.
لكنني اكتشفت لاحقا، حينما بدأت في البحث عن حضانة لابني، أن هناك أسبابا كثيرة، مبررة ومنطقية، قد تدفع الوالدين من أبناء الطبقة المتوسطة فما فوقها إلى الاتجاه للتعليم الأهلي.
هؤلاء الصغار هم استثمارنا الأمثل والأغلى على المستوى الأسري والوطني كذلك، ومن أهم الأسباب التي ربما تدفع الوالدين للتعليم المدفوع: القرب الجغرافي، وعدد الطلاب في الفصل الواحد، والاعتقاد بوجود اهتمام أكثر بالطالب، وإشراك الأهالي في العملية التعليمية بشكل أكبر.
أيضا، تعليم اللغات وعلى رأسها الإنجليزية منذ سن صغيرة، وهو من أهم أسباب طفرة المدارس العالمية، وتكاثرها كالفطر.
ومن الميزات الأخرى التي يسوّق بها التعليم الأهلي نفسه ويميزها عن التعليم الحكومي: تعليم التقنية، والاهتمام بالأنشطة اللاصفية، والأنشطة الرياضية خاصة للبنات، والتعامل الذي يُفترض أن يكون أقل صرامة وشدة، خاصة مع بعض الطلبة الذين يتميزون بالخجل، أو لديهم احتياجات إضافية، قد لا يتمكن معلم المدرسة الحكومية من تلبيتها، وهو الذي يدرّس بين 30 ـ 40 طالبا في الصف الواحد. وبالمجمل، الاعتقاد بأن المدرسة الخاصة توفر بيئة تعليمية ممتعة ومحفزة للابن أو الابنة، بحيث لا تصبح المدرسة لهم ذلك الكابوس الكريه.
هذا إذا اعتبرنا أن هناك بديلا حكوميا متوافرا كما في مراحل التعليم الأساسي، أما مراحل ما قبل المدرسة: الحضانة ورياض الأطفال والتمهيدي، والتي لا يكاد يتوافر لها بديل حكومي، فإن العائلة ليست أمامها من خيار إلا التعليم الأهلي، إما لأن الأم عاملة، أو لرغبتها في تطوير مهارات الطفل، وإشراكه مع أقرانه في اللعب، خاصة من سن الثالثة وما فوق.
وعلى الرغم من وجود قرارات حكومية تلزم المنشآت الحكومية، كما الخاصة، والتي يزيد عدد موظفاتها عن نسبة معينة بإنشاء حضانات وروضات في مقر العمل، فإن هذه القرارات ما زالت حبرا على ورق، إلا ما ندر.
وحين يتم توفيرها، كما هي الحال في بعض الجامعات، فإن هذه الحضانات ليست مجانية، وتوجد قوائم انتظار طويلة لها بالسنوات، نظرا لعدم تساوي حجم هذه الحضانات وعدد موظفاتها مع عدد الطالبات والإداريات والأكاديميات في الجامعة الواحدة.
لا شك أن الحصول على الخدمات الإضافية التي يقدمها التعليم الأهلي له ثمن، وهو أمر يدركه الأهالي الذين يختارون هذا الطريق، وهم يعلمون أيضا أنه ليس كل المدارس متكافئة في المباني والتجهيزات والكادر التعليمي والمنهج الدراسي والأنشطة اللاصفية وغيرها، وبالتالي طبيعي أن تتفاوت الأسعار، وإن كانوا يتوقعون وجود سقف أعلى لها. لكن ما لم يكن جُلّهم يتوقعه حين بدأ الإبحار في هذا الاتجاه، هو أنه سيقع فريسة لما يمكن تسميتهم “تجار التعليم”!
بعض هؤلاء التجار يقدمون خدمة جيدة، والبعض الآخر يقدم بضاعة مزجاة، لكنهما يتعاملان مع الطالب وذويه أولا من مبدأ التاجر الذي يهمه الربح الكبير والسريع، أكثر مما تهمه مصلحة الطالب، فهو لا يشعر أنه يقدم رسالة، حتى وإن كانت رسالة فيها شيء من الربح المستحق والمعقول، وإنما هو يقدم سلعة قبل كل شيء.
والمزعج في موضوع الرسوم المرتفعة، هو أنها لا تنعكس إيجابيا على الطالب أو المدرسة أو حتى المعلم. فما زال معلم المدرسة الأهلية يعاني من ضغوطات في العمل مقابل راتب زهيد، خاصة إن كان سعوديا أو سعودية، بل لا يوجد حماس للسعودة حتى في المواد التي يفترض أن يدرّسها سعوديون، مثل اللغة العربية والدين الإسلامي والتاريخ والوطنية.
هذه الرسوم الدراسية تجاوزت كل حد معقول، فهي من ناحية مرتفعة جدا، وسأذكر هنا مثلا مرحلة رياض الأطفال، إذ قمت بجولة على أكثر من 10 مدارس في مناطق مختلفة من مدينة جدة، فوجدت أن أقلها يبدأ من 9 آلاف ريال ويستمر الرقم في التصاعد حتى يتجاوز 30 ألفا!
وهذه الـ30 ألفا لا تشمل إلا رسوم الدراسة، وهنا تأتي الناحية الثانية، وهي أنه علاوة على أنها مرتفعة، فإنه يتم التحايل عليها واستنزاف الأهالي لدفع مزيد من الأموال عبر اختراع رسوم أخرى، ربما تصل هي في حد ذاتها إلى أكثر من 5 آلاف ريال، وذلك لتغطية ما يلي: فتح ملف، والتسجيل، والزي المدرسي، والكتب المدرسية، والحفل الختامي، وفي بعض الحالات رسوم غداء، أو –وهو ما استفزني شخصيا في بعض الروضات العالمية- رسوم تعليم القرآن والعربية! بينما يفترض أن تلزم الوزارة المدارس الأهلية جميعها –ما عدا التابعة لسفارات دولها– بتدريس هاتين الركيزتين الأساسيتين في التعليم السعودي.
وهذه الرسوم في ازدياد مضطرد غير منطقي ولا مبرر، وفي ذلك ابتزاز علني للأهالي، فأن تدخل ابنك مدرسة ابتدائية، وأنت قد قبلت رسومها المرتفعة، فهذا لا يعني أنه يحق لها فرض زيادة إجبارية عليك كل عام، وهي إجبارية لأنه ليس من السهل أن تنقل ابنك إلى مدرسة بنظام مختلف، أو حتى بالنظام نفسه، ولا أن تختطفه من بيئته التي تعود عليها، وزملائه وأصدقائه وعالمه الصغير. إحدى المدارس التي اتصلت بها العام الماضي كانت رسومها 18 ألفا، وعندما تواصلت معهم هذا العام عرفت أن التكلفة باتت 22 ألفا دون رسوم التسجيل والاختبار.
نعم، اختبار قبول لطفل في مرحلة الروضة، من إدارية غير متخصصة، تعطيه مجموعة من المكعبات ليرتبها خلال بضع دقائق يكلف 150 ريالا! ترى هل تعلم الوزارة عن هذه الأمور؟ وما موقفها منها؟
وما زالت هناك عدة نقاط عن التعليم الأهلي عامة والمدارس العالمية خاصة جديرة بالتناول لاحقا.
لماذا نسافر؟
 السفر للسياحة ليس عيبا، بل هو من متع الحياة الدنيا المباحة التي يحلم بها الغني والفقير، ويمارسها الأشخاص من كافة البلدان والثقافات. فحتى لو كانت بلادك جنة الحياة الدنيا، فسيكون لديك توقٌ لتتعرف على الثقافات والبلدان الأخرى، على أناسها وطبيعتها وأجوائها وطعامها وأسواقها.
السفر للسياحة ليس عيبا، بل هو من متع الحياة الدنيا المباحة التي يحلم بها الغني والفقير، ويمارسها الأشخاص من كافة البلدان والثقافات. فحتى لو كانت بلادك جنة الحياة الدنيا، فسيكون لديك توقٌ لتتعرف على الثقافات والبلدان الأخرى، على أناسها وطبيعتها وأجوائها وطعامها وأسواقها.
لذلك، ليس غريبا أن تجد سويديا يسيح في سريلانكا، أو أميركيا يزور غانا.
السعوديون كغيرهم، يحبون السفر للسياحة، سواء للبلدان القريبة أو البعيدة، ولا مشكلة في ذلك، سوى أنه مؤخرا بات ملاحظا أن نسبة لا بأس بها منهم، باتت تتحين كل إجازة وكل فرصة للسفر خارج الوطن، بما في ذلك عطلة نهاية الأسبوع، وإجازة اليوم الوطني “قامت الخطوط السعودية بتخفيض سعر التذاكر الدولية بمناسبة اليوم الوطني!”، خاصة لمن يسكنون بالقرب من حدود دول أخرى.
ونظرة بسيطة إلى جسر الملك فهد الذي يربط المنطقة الشرقية بمملكة البحرين مساء كل خميس وسبت، يكفي دليلا ظاهرا للعيان.
أظهر استطلاع بسيط قمت به من خلال “تويتر” شارك فيه 437 شخصا، بأن 56% من هؤلاء يسافرون للسياحة الخارجية مرة في السنة، مقابل 20% مرتين، و14% ثلاث مرات، وأخيرا أقر 10% منهم بأنهم سافروا أكثر من 3 مرات في السنة خارج المملكة للترفيه.
وتتراوح فترات السفر بين اليومين والشهرين، بحسب الالتزامات الأسرية والمادية والدراسية أو العملية، وبات طبيعيا أن تسمع عمن يسافر بقرض، أو بالاعتماد على البطاقات الائتمانية، أو من خلال دخول جمعية.
كل ذلك يُظهر أن الرغبة في السفر باتت شديدة وملحّة لدرجة باتت للبعض وكأنها من الأولويات، بعد أن كانت من الكماليات التي يقوم بها العرسان أو أصحاب الدخول المرتفعة مرة في السنة. فما السبب؟ وقبل ذلك، هل يمثل ذلك مشكلة؟
سأبدأ بالإجابة عن السؤال الثاني، وهو أنه ربما يشكل مشكلة، لما فيه من صرف للأموال الطائلة خارج أرض الوطن، وإرهاق لميزانية هذا المواطن كما للدولة، فلا تُخلق الوظائف، ولا يحصل التحول الاقتصادي المأمول، كذلك لن يتطور القطاع السياحي السعودي، ولن تتولد الأفكار الترفيهية المتميزة، وسينشأ جيل لا يعرف من وطنه إلا مدينته ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ستغدو بلاده بالنسبة له مكانا للسكن والدراسة والعمل، لا مكانا لصناعة الذكريات الجميلة وعيش اللحظات السعيدة.
لقد بات بعض المواطنين يصرح علنا بأن علاقته بالوطن باتت أشبه بعلاقة الأجنبي القادم بتأشيرة عمل إليها: بذل الجهد طوال العام لتجميع ما يكفي من المال الذي سيصرفه لاحقا في شهر أو أقل “يعيشه” خارج الوطن.
فلماذا إذًا نسافر بهذه الكثافة؟
سيحاول البعض أن يرمي باللوم على طبيعتنا الصحراوية الحارة وشمسنا اللاهبة والغبار والأتربة، وهي أمور لا يد لنا فيها، وكان يمكن تصديق هذا الادعاء لولا أننا نهرب من مدننا الصحراوية الجافة أو الرطبة، إلى مدن أكثر جفافا ورطوبة وحرا.
فالمنامة ودبي والدوحة وحتى الكويت العاصمة، تمتلئ بنا في عز الحر أو البرد، في الأعياد والإجازات وفي أيام الامتحانات! حتى لو كان عبور جسر المحبة المزدحم سيستغرق منك 3 ساعات كاملة! رغم أن دبي لا تحتضن الأهرامات، ولا تقبع أبوظبي على ضفة نهر الفرات، ولن تجد في أسواق الدوحة ما لا تجده في الرياض.
فلماذا إذًا نسافر لهذه المدن وإلى غيرها بهذه الكثافة والاستمرارية؟
هناك سببان رئيسيان، مرتبطان ببعضهما بشكل كبير: الأول، أن بلادنا للأسف ما زلت بدائية في البنية التحتية للسياحة مقارنة بالجيران، بل حتى مقارنة بدول من دول العالم الثالث، التي رغم فقرها، استطاعت أن توفر للسياح ما يبحثون عنه.
بيئتنا السياحية ابتداء من المطارات مرورا بوسائل النقل وصولا إلى أماكن الترفيه والفنادق، لا ترقى إلى الحد الأدنى المطلوب، والذي بات السعودي، من الطبقة المتوسطة وما فوقها يقبل به، وفوق ذلك تُقدم بأسعار هائلة.
ومن المؤسف، أنه كانت لدينا فرصة ذهبية في بداية الألفية للنهوض بهذا القطاع، خاصة في المناطق ذات الطبيعية المميزة والجو البديع صيفا كأبها والطائف.
أتذكر أنني زرت أبها وقتها ولمست بداية واعدة لأن تصبح محجا سياحيا، وكانت المنطقة آنذاك تمتلئ بالسيارات التي تحمل لوحات دول الخليج المختلفة، وكانت سبّاقة في بعض المشروعات السياحية العملاقة والجديدة كالعربات المعلقة. وكان اسم أبها على كل لسان، لكن سرعان ما خف الوجه، وصار الكل يردد اسم دبي بدلا منها.
إن افتقار المملكة إلى أبسط وسائل الترفيه، كدور السينما مثلا، يجعل السعودي يسافر إلى البحرين بشكل أسبوعي فقط ليشاهد فيلما حتى لو كان فيلم الأطفال: البحث عن دوري! ويدفع رسوم الجمارك وتأمين السيارة على الحدود فقط ليحقق هذا الهدف.
المسؤولون عن السياحة يروجون لها كمنتج “وطني”، يتم تسويقه من باب العواطف وحب الوطن، وليس من خلال تقديم ما يرضي السائح أيا كان، وهو ما فعلته دبي.
السياحة مثل الأكل والملبس، إن لم يناسبك الطعم أو المقاس، فلن تشتريهما بدافع الوطنية.
قبل بضعة أشهر، تم الإعلان عن إنشاء هيئة الترفيه، وهو أمر استبشرنا به لأنه تضمن الاعتراف–أخيرا- بأن الترفيه بات من ضرورات الحياة في بلد آمن مستقر، ويستحق أن ينال الرعاية والاهتمام، ولكن للأسف جاء الصيف وانقضى، والناس تسأل: أين الهيئة؟
أما السبب الثاني، ولعله الأهم، هو أن الحياة في السعودية فيها كثير من القيود والأنظمة واللوائح والتعاميم، وهي أمور نتعايش معها كل يوم، لأننا لا نملك خيارا آخر، وهي غالبا أنظمة وضعتها أجيال سابقة، وتعاني منها الأجيال الحالية، فحين ترغب في أن تستمتع بالإجازة فأنت تبحث عن كسر هذا الروتين وهذه القيود، وعن التحرر مما هو مفروض عليك.
وغني عن القول، إن ما أقصده هنا لا يعني التحرر من تعاليم شرعية لا لبس فيها، فكاتبة هذه السطور امرأة مسلمة متحجبة داخل بلادها وخارجها، ولا تبحث في الخارج عما ستخجل من القيام به في الداخل لو سُمح به.
لكن، حين تذهب للسياحة فتجد من يحصي عليك أنفاسك، وماذا تلبس، وكيف تلعب، وأين تأكل، فلا شك أنك –لو كنت مقتدرا- ستبحث عن بديل يسمح لك أن تكون أنت كما أنت، رقيبا على نفسك، وصيّا عليها وعلى أسرتك فقط، وليس على الآخرين وأسرهم.
وحتى يتغير الحال، سيظل السعودي في رحلة العودة من كل إجازة ينظر في التقويم السنوي عن موعد الإجازة القادمة، حيث تنتظره رحلة أخرى.. خارج الحدود.
عندما يمرض أجنبي في بريطانيا
 الحديث عن تطوير الأنظمة الصحية هو أحد أكثر المواضيع إثارة للجدل على النطاق العالمي، لأنه ببساطة يتعامل مع أهم ما يملكه الإنسان: صحته وبالتالي حياته. والنظام الصحي الجيد هو أحد الأمور الجوهرية التي يتم بها قياس مدى تطور دولة ما، والتزام حكومتها بتوفير احتياجات سكانها الأساسية، وعلى رأسها دوما الصحة والتعليم. وحين أذكر سكانها، لا أفرق بين مواطن ومقيم فيها، فما دامت إقامته نظامية، وما دام يدفع الضرائب، أو رسوم هذه الإقامة، فلا أرى بأنه مقبول قانونيا أو إنسانيا أن يُحرم هو أو من يعول من هاتين الخدمتين الرئيسيتين اللتين هما بمثابة الماء والهواء.
الحديث عن تطوير الأنظمة الصحية هو أحد أكثر المواضيع إثارة للجدل على النطاق العالمي، لأنه ببساطة يتعامل مع أهم ما يملكه الإنسان: صحته وبالتالي حياته. والنظام الصحي الجيد هو أحد الأمور الجوهرية التي يتم بها قياس مدى تطور دولة ما، والتزام حكومتها بتوفير احتياجات سكانها الأساسية، وعلى رأسها دوما الصحة والتعليم. وحين أذكر سكانها، لا أفرق بين مواطن ومقيم فيها، فما دامت إقامته نظامية، وما دام يدفع الضرائب، أو رسوم هذه الإقامة، فلا أرى بأنه مقبول قانونيا أو إنسانيا أن يُحرم هو أو من يعول من هاتين الخدمتين الرئيسيتين اللتين هما بمثابة الماء والهواء.
بل إن الملف الصحي كثيرا ما أسهم في فوز ناخب ما أو سقوطه، ولعل برنامج الرئيس الأميركي باراك أوباما “أوباما كير”، والذي حاول من خلاله الحد من تغول الرأسمالية في هذا القطاع، حيث إن الوضع السائد في الولايات المتحدة، التي تعد من أكثر الدول تقدما في المجال الطبي، أن هذا العلاج متاح للأميركيين وغيرهم عبر التأمين الطبي، الذي هو في استطاعة الأغنياء دون الفقراء. فما فائدة أن تقيم في دولة لديها أحدث الأجهزة الطبية، وأنجع البرامج العلاجية، وأمهر الطواقم الطبية، وأفضل مراكز الأبحاث، ولكنك تحرم منها فقط لأنك لا تملك المال الكافي؟ وقد حورب الرئيس الأميركي كثيرا من قبل كل الأطراف المتنفذة والمستفيدة مثل شركات التأمين والأدوية والمستشفيات وغيرها.
والغريب أنه في حين حاول الرئيس الأميركي أن يستلهم النموذج الأوروبي، الذي رغم أن اقتصاده يقوم على الرأسمالية أيضا، لكنها رأسمالية اجتماعية وإنسانية، تأخذ بالاعتبار احتياجات الإنسان الأساسية، وتراعي الأغنياء كما الفقراء، فإن أصوات المتنفذين في بعض الدول الأوروبية تطالب بالخصخصة على الطريقة الأميركية، ومنها المملكة المتحدة التي لديها النظام الصحي الشهير (NHS)، الذي يوفر الرعاية الطبية بالمجان للمواطنين، ولكل من يقيم لمدة ستة أشهر فأكثر بشكل نظامي في البلد، بما في ذلك الطلبة الأجانب. ولسنوات طويلة ظل الطلبة السعوديون وعائلاتهم يستفيدون منه، إذ لم يكن لهم تأمين صحي من الملحقية حتى بضع سنوات خلت. وللأسف فإن هناك لدينا من يريد أن يفعل الشيء ذاته، وأن يحرم ملايين المواطنين السعوديين، بعد أن تم حرمان المقيمين، من الرعاية الصحية المجانية، عبر خصخصة القطاع الصحي، ويجادل هؤلاء بأنها الطريقة الوحيدة لتحسين هذا القطاع والنهوض به. ولو سمعهم الأصدقاء في الدول الإسكندنافية التي تقدم رعاية صحية بمعايير عالمية مذهلة بالمجان لتعجبوا كثيرا. صحيح أن الضرائب في الدول الإسكندنافية تعد عالية، إلا أننا لا نجد المرء هناك يتذمر منها، لأنه يعرف بالضبط كيف تُصرف، ولأنه يجد بالمقابل خدمات تعليمية وصحية هي الأفضل على مستوى العالم. كما يتحمل الأغنياء والمقتدرون مسؤولياتهم تجاه الفقراء واللاجئين وغيرهم ممن يستفيدون من الخدمة دون دفع الضريبة ضمن نظام متكامل جدير بالإعجاب. فالعقلية الأوروبية تتفهم بأن الحلقات الأضعف في المجتمع تستحق الرعاية والاهتمام والدعم، وأن العجز أو المرض أو الفقر ليس منقصة أو عيبا، وهي تختلف بذلك جذريا عن العقلية الأميركية التي يصرح الناس فيها علنا بعدم رغبتهم في دفع ضرائب عالية من أجل الفقراء، فهم ليسوا مسؤولين عنهم، وأن تكون فقيرا في أميركا – بلد الفرص- في نظرهم يعني بأنك إنسان فاشل وكسول، ولا تستحق دعما حكوميا، وإن تكرمت الحكومة وأعطتك يتم النظر لك كطفيلي يقتات على مجهود الآخرين.
نعود للنظام الصحي البريطاني، الذي لم يتغير بعد، والمثال الذي أرغب بذكره هنا هو لسائح سعودي شعر ببعض التعب، فتوجه إلى ما يعرف بالعيادة المفتوحة Walk in Centre)) حيث يمكن أن تحصل على موعد فوري لتقابل ممرضا متخصصا، فقامت الممرضة بأخذ القياسات اللازمة مثل الحرارة والضغط وغيرهما، وعندما لاحظت مشكلة في انتظام ضربات القلب، وبسبب سنه، قامت مباشرة بالاتصال بالإسعاف، لأنها أرادت أن تختصر عليه فترة الانتظار في الطوارئ، ومنعا لأية مخاطرة في صحته. وصل الطاقم المسعف في فترة وجيزة، فسلمتهم تقريرا سريعا عما قامت به، شكروها وقاموا بالمزيد من الإجراءات أثناء نقله، وبعد دقائق كان في مستشفى جامعي حكومي، وقام المسعفون بتسليم المريض إلى العاملين في الطوارئ، وسلموهم تقريرهم كذلك. تسلم هؤلاء المريض، قاموا بمراقبة ضربات قلبه، وتدرج العاملون الصحيون الذين تعاملوا معه ابتداء من ممرض وطبيب مقيم، وصولا إلى الاستشاري. وبعد أن تم اتخاذ الإجراء العلاجي المناسب، وضع تحت الملاحظة حتى استقرت حالته، بحمد الله ورعايته، وسُمح له بالخروج.
ما أثار إعجابي في هذه القصة عدة أمور:
1 – لم يسأله أحد طوال هذه الفترة عن جنسيته أو جواز سفره، لم يقولوا “أجنبي” أو “مواطن”، كان هناك إنسان مريض يحاولون مساعدته.
2 – لم يطلبوا جنيها واحدا مقابل كل هذه الخدمات الصحية الراقية، فهذه الرعاية ضمن نظام صحي مجاني، وكونه سائحا وسعوديا لم يجعلهم يطمعوا فيه أو يرسلوا فاتورة إلى سفارة بلده.
3 – وجود بروتوكول واضح لكيفية إدارة الأمور، الممرضة لديها خبرة ومعرفة وفوق ذلك صلاحيات، وكذلك كل من المسعفين والأطباء، لا تشعر بأن الطبيب هو الحاكم بأمره والممرضة ليس لها من الأمر شيء.
4 – تخفيف الضغط عن المستشفيات، فللحالات البسيطة هناك هذه المراكز (Walk in Centre)، وبعدها هناك الحصول على موعد مع طبيب عام (GP) في العيادة المحلية الخاصة بكل حي أو عدة أحياء، والذي يقوم بدوره بتحويل المريض الذي تستدعي حالته ذلك إلى المستشفى. وهناك خدمات الطوارئ والإسعاف، ورعاية الحوامل، ورعاية الأم والمولود بعد الولادة من خلال الزيارات المنزلية، ومراكز رعاية الأطفال ومتابعة نموهم وتطعيماتهم، ورعاية المسنين، وذوي الاحتياجات الخاصة ودعم أسرهم. طبعا ليست كل هذه الخدمات مثالية، وستجد من يتشكى منها، ويعدد لك عيوبها، لكن ما يمكن التأكد منه أن الرعاية الصحية الأساسية متوفرة للإنسان أيا كان.
هذا المقال مهدي إلى: من يعتقدون بأنه ليس من واجبنا تقديم أية رعاية طبية مجانية لغير السعوديين حتى في الحالات الطارئة، أو الأمراض القاتلة، ولمن لا يشعرون بالخجل والعار من أن يرفض طوارئ مستشفى حكومي استقبال امرأة غير سعودية في حالة وضع، ولمن يعتقدون بأن الحل في التأمين الطبي الإلزامي، ولمن يريدون أن يسرقوا من المواطن نظام العلاج المجاني، تحت وعود زائفة بتقديم خدمة أفضل، وأخيرا لمن يعتقدون بأن النظام الطبي الناجح يقوم على أكتاف أمهر الأطباء المتخصصين فقط، مهملين تطوير وتدريب باقي العاملين المهمين في هذا المجال.
August 25, 2016
ما بين 1996 و2016: كيف فعلتها بريطانيا؟
النجاح ليس وليد الصدفة، وإنما يعود الأمر إلى الأسباب الرئيسية لنجاح أي مشروع: تخطيط سليم، وإدارة واعية، ودعم مادي مدروس، وشفافية ومحاسبة، وبناء روح الفريق، واستقطاب المواهب، والزخم الإعلامي
أسدل الستار أخيراً على أولمبياد ريو 2016 بنجاح كبير للدولة المستضيفة، وللألعاب نفسها وللرياضيين. كان في هذه الدورة الكثير من كل شيء، من المظاهرات المحلية إلى السياسة وفضيحة روسيا مع المنشطات، إلى الأرقام القياسية الجديدة التي تم تسجيلها، والرياضيين الذين صنع بعضهم التاريخ، والبعض الآخر خرج منه بسبب سلوكيات غير مسؤولة. فمما لا شك فيه أن أولمبياد البرازيل كانت مميزة ومختلفة واستثنائية منذ حفل الافتتاح حتى إعلان النتيجة النهائية، والتي كانت بدورها مفاجأة! فليس غريباً أن تحل الولايات المتحدة الأميركية في المركز الأول، لكن المختلف هذه المرة أن الوصيف لم يكن سوى المملكة المتحدة، التي حققت للمرة الأولى في تاريخها 27 ميدالية ذهبية و23 فضية و17 برونزية (المجموع 67 ميدالية)، مما جعلها تدفع بالصين إلى المركز الثالث، وسط ذهول البريطانيين قبل الصينيين! فكيف استطاعت هذه الجزيرة الصغيرة بسكانها البالغ عددهم 65 مليوناً هزيمة بلد بحجم الصين بسكانها الذين يتجاوز عددهم المليار نسمة؟
لم يكن الأمر وليد الصدفة، خاصة بالرجوع إلى الوراء قليلاً، تحديداً إلى عشرين سنة خلت، إلى أولمبياد أتلانتا 1996 في الولايات المتحدة الأميركية. يومها خرجت بريطانيا العظمى بميدالية ذهبية يتيمة وبضع ميداليات أخرى فضية وبرونزية، مما يجعل المجموع ككل 15 ميدالية فقط، وحلت بريطانيا يومها في المركز الـ36 في جدول التصنيفات النهائي. وظل المسؤولون عن الرياضية في هذا البلد يفكرون ويخططون لتغيير هذه الأرقام المتواضعة. بل إن استضافة الألعاب الأولمبية في لندن 2012 كانت جزءاً من هذا التخطيط، وإن لم تكن النتائج المتحققة على الصعيد الرياضي يومها بعظمة ما تحقق بعدها بأربع سنوات في البرازيل.
يذكر البريطانيون عدة أسباب لهذا التحول والنجاح الكبير. فهناك الإنفاق المالي الكبير على الرياضات المختلفة وليس على رياضة واحدة ككرة القدم، سواء كان ذلك في الرياضات التي تتميز فيها الدولة تاريخياً كالسباحة والدراجات والتنس والتجديف أو الرياضات الأقل شهرة. لكن ذلك الإنفاق لم يكن غير مشروط، بل كان فيه ما يمكن اعتباره شدة أو قسوة أو حزماً. كان الدفع والدعم والإنفاق على رياضة ما مرتبطاً بالأداء، فحين يفشل الرياضيون في تحقيق أهداف مرضية في المسابقات والمحلية والدولية وفي أثناء الاستعدادات للأولمبياد، فإن هذا الدعم ينقطع حتى يتحسنوا. ولم تكن المحاسبة خاصة بالرياضيين، وإنما بعد كل إخفاق تتعرض الاتحادات الرياضية لكل لعبة لمحاسبة دقيقة، نتج عنها أحياناً فصل رؤساء هذه الاتحادات، واستبدالهم بمن يستطيع أن يحقق ما هو مأمول منه. كما أن لسياسة النفس الطويل دوراً، فبدلاً من وضع خطة فقط للأولمبياد المقبلة بعد أربع سنوات، يتم وضعها لثماني سنوات، وذلك يشمل الميزانيات والتدريبات والأهداف، فسياسة النفس القصير قد لا تكون مجدية لصنع التغيير الكبير والدائم.
وإضافة إلى الأمور المادية والإدارية فهناك الأمور المعنوية. فقد استفادوا من دور المشاهير أو “السوبرستارز”، لكن هؤلاء لم يكونوا مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي، ولكن الأبطال الذين حققوا بالفعل نجاحات في بطولات سابقة وحصدوا الذهب والفضة والبرونز. فقد بات هؤلاء أيقونات يعرفهم الجميع ويظهرون بشكل متكرر على التلفاز وفي المناسبات العامة، بل ويزورون المدارس ليحمسوا الطلبة على صناعة الحلم الأوليمبي. وبالفعل فإن إحدى الصغيرات التي تأثرت بزيارة أحدهم قبل عشر سنوات في مدرستها شاركت كرياضية في أولمبياد ريو 2016!
كذلك تم العمل على إحياء الروح الوطنية بين الرياضيين، وهم تحدٍ كبير بالنسبة للمملكة المتحدة، التي تتكون من أربعة أقاليم كانت فيما سبق دول مستقلة لكل منها عاداتها ولغاتها. خاصة أنهم يلعبون في رياضات أخرى مثل كرة القدم بشكل منفصل وليس كدولة واحدة. فتم التركيز هنا على بناء روح الفريق، وأن نجاح كل واحد منهم في رياضته وتحقيق الذهب هما اللذان سيرفعان الفريق ككل إلى منصة التتويج، فالتصنيف النهائي لفريق وليس للعبة منفردة. والإعلام كان مسانداً بشكل كبير فلا تسمع إلا الحديث عن فريق GB. ومن الأساليب التي تم اتباعها لجعل الرياضي يحس بقيمة شعار الفريق الذي يرتديه، تم سحب الملابس أو عدة الرياضة التي تحمل هذا الشعار منهم بعد الأولمبياد السابقة وإعطاؤها لهم قبل بدء الحالية، لإيصال فكرة بأن هذه الأشياء قيمة بحيث لن ترتديها إلا مرة كل أربع سنوات.
هناك أمور أخرى قد تكون مرتبطة بالسياسة أكثر منها بالأولمبياد، ولكنها توضح كذلك كيف يمكن أن تحقق كبلد مردوداً إيجابياً من خلال استضافتك للمهاجرين واللاجئين وإعطاء بعضهم الجنسية واحتضان الموهوبين منهم ومنحهم فرصاً متساوية مع أبناء البلد. العداء محمد مختار فرح (33 عاماً)، خطف الأنظار في ريو 2016، ليس لأنه حقق ميداليتين ذهبيتين في سباقي 5000م و10000م للرجال فقط، ولكن لأنه سقط في بداية أحد السباقين، ولكنه نجح في النهوض وإكمال السباق والفوز بالمركز الأول! هذا الرجل من أصل صومالي، ولد في مقديشو، ونشأ في جيبوتي، قبل أن يصل إلى بريطانيا في عمر الثامنة وهو لا يجيد كلمة إنجليزية واحدة آنذاك. وبريطانيا التي منحته جنسيتها ورعايتها الطبية والتعليمية والرياضية جنت ما زرعت، فقد بات اليوم أكثر رياضي بريطاني نجاحاً في تحقيق الذهب، فقد حقق الميداليتين ذاتهما عام 2012 في لندن ودافع عن لقبه في ريو 2016. وهو إنجاز عالمي وتاريخي، فلم يسبقه في رياضته سوى عداء واحد من فنلندا اسمه لاسي فيرن، وعمره اليوم 67 سنة، أي أنه مضى وقت طويل حتى استطاع رياضي تكرار إنجازه.
وإذا ذهبنا إلى المستوى الشعبي لخلق هذا المجتمع الذي يمارس الرياضة ويدعمها، نجد أن هناك على مستوى الأحياء في كافة المدن والقرى البريطانية نوادٍ رياضية حكومية شبه مجانية، لتمكين الجميع من ممارسة الرياضة. وفي بعض المدن فإن المسابح تخصص ساعة أو أكثر أسبوعياً للنساء فقط، بحيث تتمكن المرأة المحجبة مثلاً من الاستمتاع مثل الآخرين مع مراعاة قيمها. النجاح ليس وليد الصدفة، وشعوب دول معينة ليسوا بأفضل من أخرى لجهة التكوين الجسدي، أو القدرة على تحقيق النتائج المذهلة. وإنما يعود الأمر إلى الأسباب الرئيسية لنجاح أي مشروع: تخطيط سليم، وإدارة واعية، ودعم مادي مدروس، وشفافية ومحاسبة، وبناء روح الفريق، واستقطاب المواهب، والزخم الإعلامي والقوة الناعمة. فإذا ما كان العرب يرغبون في أن يتجاوزوا مرحلة المشاركة لرفع العتب، فليسوا مضطرين لشراء اللاعبين واللاعبات، وإنما عليهم البدء بأخذ الرياضة بجدية، ابتداء من ملعب المدرسة وحصة التربية البدنية، فالسماء لا تمطر ذهباً ولا فضة، لكن التخطيط والعمل يصنعان المعجزات.
مرام عبد الرحمن مكاوي's Blog
- مرام عبد الرحمن مكاوي's profile
- 36 followers