باسم سليمان's Blog, page 7
May 30, 2024
المرأة بالسيَر الشعبية: فارسة وحكيمة لا يُشق لها غبار
باسم سليمان 29 مايو 2024
يحتوي التراث العربي على مدونة سردية كبيرة تُسمى السّيَر الشعبية، نذكر منها (عنترة – ذات الهمّة – الهلالية) على سبيل المثال. وتمتاز هذه السّيَر بأنّها قدّمت مخيالًا شعبيًا مختلفًا للتاريخ، عمّا عهدناه في الثقافة الرسمية للتراث العربي. فهي لم تسلك طريق الرواية المعتمدة للتاريخ، فقد كانت تخالفه في كثير من الأحيان، على الرغم من استنادها عليه. ففي السيرة الشعبية لحمزة البهلوان، يحلم كسرى أنو شروان صاحب التاج والإيوان في بلاد فارس حلمًا يقضّ مضجعه، فيفسّره له وزيره بُزرجمهر، بأن مُلكه سيذهب، وسيعيده إليه فارس عربي يظهر في بلاد الحجاز. هذه المخالفة للتاريخ الحقيقي لا يُقصد منها تزوير التاريخ، بل تحقيق مطالب نفسية اجتماعية للشعوب العربية الإسلامية التي فتحت بلاد فارس في مواجهة الحضارة الفارسية التي كانت تفوق العرب بالكثير. لقد كان التنافس بين العرب والفرس المهزومين إبّان الحركات الشعوبية، التي بدأت تظهر في العصر العباسي، يأخذ منحى تنافسيًا، ومن أجل ذلك تأتي سيرة حمزة البهلوان لتخلق فضلًا للعرب يسبق ظهور الإسلام، الذي سادوا به على بقية الشعوب ومنهم الفرس. يذكر الجاحظ في (التاج في أخلاق الملوك) بأنّ العرب أخذوا الآداب السلطانية عن الفرس من مُلك ومملكة وترتيب الخاصة والعامة وسياسة الرعية وإلزام كل طبقة حظّها في السلّم الاجتماعي. تشير مقولة الجاحظ إلى هذا التنافس المضمر بين الشعوب التي دخلت الإسلام، مع أنّه قد وحّد بين أتباعه.
هذه المنافسة كان يجب أن تظهر وخاصة أنّ الإسلام جعل التفاضل بين الشعوب والأفراد والأمم بالتقوى، وأسقط من يدهم أسباب التفوّق السابقة: “لا فضلَ لِعربِيٍّ على عجَمِيٍّ ولا لِعجَمِيٍّ على عربيٍّ ولا لأحمرَ على أسْودَ ولا لأسودَ على أحمرَ إلَّا بالتَّقوَى”. لكن الأمر الديني هو رؤية مثالية لم يكن من السهولة تطبيقها في الواقع، فظلّت المنافسة قائمة، بهذا التفسير نفهم لماذا أعدّ الفردوسي للسلطان محمود الغزنوي الذي يعود بنسبه من جهة الأم إلى الفرس؛ كتاب (الشهنامة) الذي يحتوي سيرة الفرس من الأزمنة الأسطورية إلى الفتح الإسلامي، وكأنّه يقول له، لقد جمعت المجد من أطرافه؛ أصالة المحتد والتاريخ والإيمان بالإسلام، وبذلك خطب ودّه.
ما نريد قوله من هذه المقدّمة أنّ السّيَر الشعبية لم تكن مجرد تخيل مجاني يهدف إلى المتعة والتسلية فقط، فسيرة (علي الزيبق) تُظهر طبقة العوام وفضلها من شطّار وزعّار وعيّار – صفات ذم كان قد أطلقها مؤرخو السلطة على العوام – والذين كان لهم دور في الانتفاضات الشعبية التي هدّدت السلطات في بغداد والشام ومصر، حيث ذكرهم مؤرخو السلطات بالكثير من التشفّي والحقد، فجاء ردّ هذه الطبقة الشعبية العامية بإيجاد أبطال شعبيين متخيّلين، وإن كان لبعضهم أثر واقعي كعلي الزيبق، إلّا أنّه أصبح في السيرة بطلًا شعبيًا يقف في وجه مظالم مقدّم الشرطة في مصر صلاح الدين الكلبي، حتى نال منه، وأستطاع أن يكون مقدمًا على مصر، بل إنّ هارون الرشيد أعطاه مقدمية بغداد. ونضيف إلى ذلك بأنّ هؤلاء الشطّار والعيّار استطاعوا تحقيق الأمن والعدالة من شرق الدولة الإسلامية إلى غربها، حتى أنّهم أنجزوا وحدة لم تعرفها في تاريخها.
لقد كانت هذه السّيَر حاجة داخلية لطبقة العوام، لتكون على ساحة التاريخ، وإن كان بالخيال. ولو قدّر لغوستاف لوبون أن يلحظها لاعتبر السّيَر الشعبية العربية أول حركة تاريخية للجمهور غيّرت الواقع، لكن على صعيد الخيال، قبل أن تغيّره الجماهير فعلًا في أوروبا. وهو يخالف المفكّر (سيجهيل/ Sighele) الذي كان يعتبر الجماهير مجرمة بطبيعتها. ولا يختلف قول سيجهيل عن رأي الثقافة العربية التراثية بالعامة، فقد كانت تصف العامة بأنّهم دهماء وحتى بقر. يقول لوبون في كتابه (سيكولوجيا الجماهير): “إنّ الميزة الأساسية للجمهور هي انصهار أفراده في روح عاطفية مشتركة تقضي على الفروق الشخصية”. وبعد أن انتهى من تحديدها، شرع في شرح كيفية قيادتها عن طريق التحريض، والدعاية، والقائد الملهم. ومن ثمّ أنّ الجماهير، هي من تستخدم المجاز والصور الموحية، لذلك يخطئ القائد السياسي عندما يخاطبها بالحقائق العقلية، بل عليه أن يوجّه خطابه إلى أحاسيسها ومشاعرها بالمقولات الحماسية غير العقلانية؛ وهذا ما كانت تفعله السّيَر.
بمكان ما نلحظ كيف استطاع عنترة أن يقود قبيلته لمجدها، وحمزة البهلوان كذلك، وأبو زيد الهلالي وعلى الزيبق، فهم بالنسبة لهؤلاء الجموع أبطال يسوقهم القدر إلى مجدهم.
بعد هذا التقديم المطوّل سنتطرق إلى دور المرأة في تلك السّيَر، وخاصة أنّها منحتها بطولة سيرة كاملة هي (ذات الهمّة) التي فتحت القسطنطينية على زمنها وبقيادتها.قد غيّبت المرأة في التراث العربي، وهي إن ذكرت، فيأتي ذكرها من وراء حجاب الأعراف والتقاليد. وإن كان لبعض النساء ذكر، فقد كان ممنوحًا لها تبعًا لزوجها أو أخيها أو ابنها، لكن مجرد شذرات، فلا تقوم لوحدها. وخاصة أنّ النص الديني، كما فسّرته الثقافة الذكورية، استخدم لقمع المرأة وجعلها بمثابة العورة التي يجب سترها. فلا الشعراء الذين تغزّلوا فيها منحوها جانب المبادرة، فقد ظلّت المعشوقة لا العاشقة، حتى أنّ كلمة العشق كانت مستهجنة في التراث العربي لأنّها تخصّ الأنثى، وكما تقول رجاء بن سلامة في كتابها (العشق والكتابة) فإنّ كلمة العشق تعود إلى الناقة التي تحنّ إلى فحلها وتظهر هذا التوق بجلاء؛ وهذا كان مستهجنًا من قبل الثقافة الذكورية، إذا أقدمت عليه الأنثى. وعلى الصعيد السياسي تظل مقولة: “لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة” التي قيلت عندما سُمع بأنّ الفرس ولوا أمرهم لابنة كسرى. لقد كانت هذه المقولة مدار تفسيرات كثيرة، لكنّها كانت فاعلة في تنميط المرأة في التراث العربي.
لقد قسمت النساء إلى حرّات وجوارٍ، فأكثر ما ذكره التراث عن المرأة كان يخصّ الجواري؛ سواء في الشعر والقصص والأخبار وغير ذلك. أمّا المرأة الحرّة، فبالكاد تذكر. وهنا هل نفهم بأنّ (ألف ليلة وليلة) جاءت لتردّ الحيف التاريخي عن الجارية، فأكثر القصّ في الليالي يسرد حيوات الجواري اللاتي استطعن بذكائهن ومكرهن وكيدهن أن يتفوّقن على الرجال. وإن كان من مثال لا يُرد، فقصة الجارية (تودّد) التي بزّت العلماء والفقهاء ورجال الأدب في حضرة هارون الرشيد حتى أذلتهم وأظهرت جهلهم. والأهم من ذلك، بأنّ ألف ليلة وليلة أوجدت قاعدة جمالية، بأنّ الحكاية تنجي من الموت! فالحق في إبداء الرأي، سواء بذكر قصة أو سيرة أو حكمة يقتنص منها المحكوم بالموت إعجاب السلطان، ستمنحه الحياة. هكذا استطاعت شهرزاد أن تنصف الجارية في المجتمع العربي قديمًا. ولربما لم تكن تهتم السلطات الذكورية العربية بهذا النصر الذي قدمته شهرزاد للجارية، فهي تظل مملوكة ولا تقارن بالمرأة الحرّة. وهنا تأتي السّيَر لتقف مع المرأة الحرّة من الجور الذكوري.
ذات الهمّة
إنّها ذات الهمّة، صاحبة السيرة التي تتجاوز الستة آلاف ورقة، فاتحة القسطنطينية على زمن الخليفة المعتصم، فمن هي؟
إنّها فاطمة بنت مظلوم بن الصحصاح بن جُندبة بن الحارث الكلابي. كان الحارث الكلابي زعيم قبيلة بني كلاب، وهو زعيم كبير تدين له القبائل في الجزيرة العربية. من هذا المنطلق تبدأ السيرة بالتأسيس لولادة البطلة عبر سلسلة من الحوادث الصعبة والنساء القويات اللاتي يرفضن الضيم، فجدتها (الرباب) تهرب إثر موت زوجها كي لا تسترق أو تقتل، حيث نهضت القبائل التي غزاها الحارث تطلب الثأر من قبيلة بني كلاب بعد موت الحارث. وأمام هذا الواقع الجهنمي تشدّ الرباب رحالها نحو ديرة أهلها مع عبدها، الذي يطمع فيها ويحاول اغتصابها، فتقاومه بشدّة، حتى يفاجئها المخاض، وتلد ابنها في تلك اللحظات العصيبة. وإثر ذلك يقتلها عبدها ويهرب، وقبل أن تموت تعلّق تميمة على عنق ابنها ليعرف من هو عندما يشبّ. وتدور الدوائر ويترعرع ابنها (جندبة) في قبيلة أخرى، وعندما يعرف نسبه يعود إلى قبيلة بني كلاب ويعجب بأنثى تسمى (قتّالة الشجعان) فهي فارسة في الميدان ولا ترضى زوجًا لها إلّا من يستطيع أن يهزمها في الضِراب والطعان. ومن ثم ينتصر عليها جندبة ويتزوجان ويسودان القبيلة. ويحدث أن ينقذ جندبة وزوجته أميرة أموية من هجوم قطّاع الطرق، ويغفرانها حتى تصل إلى دار أبيها، الخليفة عبد الملك بن مروان، فيطمع ابن الخليفة بقتّالة الشجعان، ويدبر مقتل الأمير جندبة ويحاول بشتى الوسائل أن يصل إلى زوجته. وأمام رفضها له وتعييره بأخلاقه السيئة يقتلها. وقد كان ولد لجندبة طفل يسمى ا(لصحصاح) يصبح فيما بعد قائدًا كبيرًا يشارك في الدفاع عن الثغور الإسلامية ضد الدولة البيزنطية، ويتزوج الصحصاح ابنة عمّه بعد مغامرات وصعاب كثيرة، فتنجب له ولدين (ظالمًا ومظلومًا)، يتقاسمان سلطة القبيلة. ولكي لا يحدث خلاف بين الأخوين أقرّت القبيلة أن تكون السلطة مقسّمة بينهما إن كان أول أطفالهما ذكرًا. وحدث أن أنجب ظالم ذكرًا اسماه (الحارث). وأنجبت امرأة مظلوم فتاة سميت (فاطمة). وأمام هذا الواقع كسرت شوكة مظلوم، وتمنّى لو أنّ فاطمة تموت، لذلك عهد بها إلى مربية وأخفى مولدها عن الناس. وحدث أن هاجمت قبيلة بني طيء قبيلة بني كلاب وسُبيت فاطمة وخادمتها. استرد بنو كلاب الغنائم من قبيلة بني طيء بهجوم مضاد، وعندما لم يجد مظلوم ابنته ومربيتها دخل السرور قلبه وانشرح صدره. تنشأ فاطمة في قبيلة بني طيء وتصبح راعية أغنام عند أحد سادات بني طيء، وعندما تكبر وتظهر ملامح الجمال عليها، يحاول أحد كبار بني طيء أن يغتصبها، فهي مجرد عبدة، ولا أحد يكترث لأمرها، لكن فاطمة كانت روحها وثّابة، فقد تعلّمت بنفسها الفروسية وضرب السيف والطعان بالرماح. وفي الوقت نفسه كانت عابدة مخلصة لله تقوم الليل والنهار. قتلت فاطمة المعتدي عليها وذهبت حججها بالدفاع عن نفسها أدراج الرياح. فتكلّف سيدها دفع ديّة كبيرة لأهل القتيل، وهمّ أن يقتلها. وهنا قالت له، أعطني سلاحًا وفرسًا وسأغنيك لولد ولدك. وطفقت فاطمة تغزو القبائل من حولها وتجلب الغنائم والأسلاب إلى سيدها حتى ذاع صيتها وسميت (داهية بني طيء). ويحدث أن تغير فاطمة على قبيلة أبيها وتأسره، وهنا يفرح الطائيون كثيرًا، ويتجهزون لقتل سيد بني الحارث. وأمام ذلك تخبرها مربيتها بأنّ مظلومًا هو والدها، فتنقذه وتعود به إلى قبيلتها وتترأس غزواتها حتى يصبح أبوها غنيًا جدًا.
هذا الواقع الجديد الذي استجدّ على ظالم دفعه للتفكير بتزويج ابنه الحارث من فاطمة وذلك لأسباب معينة، كما جاء ذكرها على لسان ظالم: “وقد عزمت أن أزوّجه بها لوجهين: الأول لجمالها، والثاني إنّها إذا صارت له، انكسرت حرمتها، وقلّ نشاطها وذهبت قوتها، وبانكسارها نبلغ من أبيها سائر الأغراض”. ترفض فاطمة ابن عمّها الحارث، ومن ثم تشترط أمام الضغط أن يهزمها في الميدان، فتهزمه شرّ هزيمة، لكنّ تحرّك البيزنطيين على الحدود الشمالية يستدعي أن تحضر ذات الهمّة لدى الخليفة العباسي في بغداد ومعها أسياد بني كلاب، وهناك بضغط من الخليفة توافق ذات الهمّة على الزواج من ابن عمّها مع أنّها أخبرت الخليفة بأنّها: “ما خُلقتُ إلّا للنّزال، لا للفراش ولا للزواج، ولا يضاجعني سوى سيفي وعُدّة حربي، وكُحل غبار النّجع مُرادي”. ترفض ذات الهمّة أن تضطجع في فراش الزوجية، لكن الحارث يدبر مكرًا يجعلها تحمل منه. وبعد أن تمرّ شهور الحمل تنجب بطل السيرة الثاني (عبد الوهاب) الذي كان أسود البشرة مع أنّ والديه أبيضان. يرفض الحارث أبوّة عبد الوهاب ويتهم ذات الهمة بأنّها اضطجعت مع عبدها. كان بإمكان فاطمة أن تقتل ابنها لكي تتخلّص من هذه التهمة، إلّا أنّها تحتضن عبد الوهاب وتربيه بأخلاق الفرسان وتشدّ الرحال لتخوض غمار الحرب ضد البيزنطيين، حيث ترتب الأقدار أن تكون أول معركة ينتصر فيها العرب على البيزنطيين في موقعة ملطية، حيث كانت قائدة جيش الأروام تُدعى (ملطية) والتي سميّت القلعة باسمها. وكانت بقوة ذات الهمّة، إلّا أنّ الجانب الروحي الكبير عند ذات الهمّة يحسم المعركة لصالحها.
قلنا بداية إنّ السّيَر الشعبية أنصفت المرأة الحرّة في مواجهة القمع الذكوري. وإذا أردنا تحليل المختصر الذي ذكرناه عن سيرة ذات الهمّة نقف عند مجموعة من النقاط: الأولى، موضوعة وأد البنات التي تمت بشكل آخر في السيرة عبر إخفاء مولد فاطمة وسعادة أبيها بسبيها من قبل قبيلة بني طيء. ويترتب على وأد الأنثى معنويًا عدم مساواتها مع الذكر، فلقد خسر مظلوم سيادة القبيلة ليسودها أخوه ظالم وأولاده من بعده، فقط لأنّه أنجب أنثى. الثانية، كانت عن الزواج، فقد رأينا قتّالة الشجعان ترفض أن تتزوج إلّا من كفءٍ لها أو أكثر؛ لذلك كانت ترفض من تهزمهم في الميدان حتى جاء الأمير جندبة. وهذا ما فعلته فاطمة فقد هزمت ابن عمّها الحارث ولم تتزوجه إلّا بضغط من الخليفة ومشورة من الفقيه عقبة السلمي الذي كان دومًا خنجرًا مسمومًا في خاصرة المسلمين وقبيلة بني كلاب، لكنّه ينتهي مصلوبًا على باب القسطنطينية بعدما فتحت بقيادة ذات الهمّة.
إنّ المضمر في هذه النقاط يكمن في أنّ عدم قيام المرأة بتفعيل طاقاتها وقدراتها، لا يعود إلى طبيعتها الجسدية والعقلية، بل لأنّ المجتمع الذكوري قد حرمها القدرة على ذلك، فقد كان يئدها في الجاهلية، ويخفيها خلف أبواب البيوت وشبابيكها فيما بعد. ومن ثم سحب منها حقّها الطبيعي في أن تكون صنوًا للذكر. لقد أثبتت السيرة على أنّ المرأة قادرة أن تكون ما تريد؛ ولأجل ذلك ندّدت السيرة بالسلطة السياسية والدينية، فلقد ازدرت الخلفاء العباسيين ولم تكرّم إلّا المعتصم بالله، ذلك الخليفة الذي استجاب لصرخة امرأة سباها البيزنطيون، فقالت: “وامعتصماه”؛ هذا من جانب السلطة السياسية. أمّا الدينية، فقد صوّرت السيرة رجل الدين فاسدًا على عكس المبادئ التي يقوم عليها الدين، فلقد فصلت السيرة بين الدين ورجاله. وأخيرًا تثبت السيرة فضل ذات الهمّة، والأحرى المرأة، بالقول بأنّ البيزنطيين كانوا يعتبرون ذات الهمّة نصف المسلمين وإذا اجتمعت مع ابنها عبد الوهاب والبطّال- أحد أبطال السيرة الكبار- أصبحوا كلّ المسلمين.
“وراء كل رجل عظيم امرأة”
قبل أن ينطق الإمبراطور الفرنسي بهذه العبارة، فقد تحقّقت فعلًا لا لفظًا في سيرة عنترة من خلال عبلة! تعتبر سيرة عنترة العبسي رمزًا لتحرير الذات من ذل العبودية. لم يكن عنترة ليدرك أنّ إقصاءه من المجتمع القبلي نهائيًا، يعود لمجرد أنّ أباه لم يعترف بنسبه لأنّه ابن جاريته السوداء؛ لو لم يقع في حب ابنة عمّه عبلة ومبادلتها إياه هذا الحب. وأمام هذا الحب كان على عنترة أن يصبح حرًا بإثبات فروسيته وذوده عن القبيلة وتم له ذلك. لقد كانت عبلة وسيلته للانضمام لمجتمع قبيلة عبس، ومن خلالها للعرب أجمعين ليصبح بطلهم المطلق وهو الأسود العبد. وحتى يتحقّق حلمه بالزواج من عبلة كان عليه أن يؤمّن مهرها المقدّر بألف من النوق العصافيري التي يملكها النعمان عامل كسرى على بلاد العرب. إنّ تأمين المهر سيقود عنترة إلى هزيمة النعمان، وكسر شوكة كسرى تباعًا، وتحريره العرب من السيطرة الفارسية. لقد أكدت سيرة عنترة بأنّ تحرّر الفرد سيقود إلى تحرّر المجتمع. وأمام هذه الصعاب التي خاضها عنترة كان يحتاج إلى دافع لا يلين، ليس من داخله فقط، بل من خارجه عبر عبلة التي رفضت كل الذين تقدموا لخطبتها، دافعة عنترة إلى أن يحقّق حريته ومتطلبات مهرها، بل لم تكتف بذلك، بل حثته ليصبح من شعراء المعلقات، وهذا أمر عظيم! ولن تقبل العرب أن يكون عبدًا زنجيًا من شعرائها وفصحائها الكبار، حتى أنّ عنترة استشار عبد المطلب ونصحه بعدم الإقدام على هذه الخطوة لأنّها ستسبّب بلبلة عظيمة بين العرب، وهو معلول النسب من جهة أمّه الحبشية. لكن عبلة أصرّت، وطلبت الهجر إن لم يقدم عنترة على ذلك، قائلة له: “ما بالك تطيل فكرك وتتحير في أمرك، أتريد أن ترجع عمّا عزمت عليه، إنّني منذ اليوم عليك حرام، حتى تعلّق قصيدة على البيت الحرام”. لقد أصبح عنترة من شعراء المعلّقات وكل ذلك كرمى لعيون عبلة. وقد أبان دور عبلة في حياة عنترة أحد شخصيات السيرة، وهو الربيع بن زياد مفسرًا للملك النعمان شخصية عنترة ودور عبلة في صناعتها: “اعلم أيّها الملك، أنّه ما جسر هذا العبد على ركوب الأهوال إلّا لعشقه لعبلة بنت مالك، فهي التي ترميه بالأمور الشداد”. وكانت عبلة تصحبه بعد الزواج في معاركه ضد النعمان والفرس مشجعة إياه: “لا شلّت يداك، ولا كان من يشناك، يا فارس الزمان، وقاهر الشجعان، وقاتل كل عدو لئيم”. وما إن يسمع عنترة صيحتها حتى ينتفض كالأسد، فيصف الراوي عنترة بعد صيحة عبلة: “وهذا عنترة لما سمع كلام عبلة زال التعب عنه والعناء، حتى كأنّه ما قاسى حربًا ولا قتالًا، ولا طعانًا، وقد تيقن أنّه ملاق وحده كل عساكر العجم غير هياب أو متخاذل”.
لقد أبرزت سيرة عنترة تكامل المرأة والرجل في المجتمع، فلا قيام لأحدهما إلّا بقيام الآخر، فلم تكن المرأة في سيرة عنترة مجرد وسيلة للتناسل والمتعة، بل كانت عنصرًا جوهريًا على الصعيد النفسي والمجتمعي، فإذا كان عنترة تمثيًلًا لمطلب الرجال بالحرية والعدالة في مواجهة المستبدين مهما كانت صفتهم، نرى أنّ هذا المطلب لن يتحقّق إلّا مع نساء كعبلة، مهما كانت قوى الرجال. وإذا كان لنا أن نتساءل لِم لم يكن عروة بن الورد الصعلوك العادل والكريم والحقيقي غير المتخيل الذي (قسّم جسمه في جسوم كثيرة) هو بطل سيرة كسيرة عنترة، فالجواب يكمن في أنّ عروة كان ينقصه امرأة كعبلة. ولكي نفهم الفرق بين دافع عنترة المتمثل بعبلة، والدافع غير المتواجد لدى عروة، الذي يقول لزوجته في قصيدته المشهورة:
أَقِلّي عَلَيَّ اللَومَ يا بِنتَ مُنذِرٍ
وَنامي وَإِن لَم تَشتَهي النَومَ فَاِسهَري.
بينما يقول عنترة:
ولقد ذكرتك والرماح نواهل
منّي وبيض الهند تقطر من دمي
فوددت تقبيل السيوف لأنّها
لمعت كبارق ثغرك المتبسم.
صاحبة ربع المشورة
وأحيانًا أخرى ثلثها، إنّها (الجازية). لقد كانت الجازية زوجة الأمير (شُكر) في السيرة الهلالية. وعندما قرّر بنو هلال الهجرة إلى تونس أدركوا بأنّ تغريبتهم لن يُكتب لها النجاح ما لم تكن الجازية بينهم. ومن أجل ذلك تحايلوا على الأمير شكر أن يبعث معهم الجازية على الرغم من الحب الكبير بينهما والولد الذي كان ثمرة هذا الزواج، إلّا أنّ الجازية تضحي بكل ذلك من أجل قبيلتها، فهي تعلم أنّ سيف أبي زيد الهلالي لن يكون كافيًا. لقد كانت الجازية العامل الحاسم في تغريبة بني هلال، فعندما أرادوا أن يجتازوا نهر النيل منعهم الحاكم (الماضي بن مقرب)، لكنّه فتن بالجازية واشترط أن يتزوّجها. وافقت الجازية وفي ليلة العرس وبينما كان بنو هلال يعبرون، شغلت الجازية الماضي بن مقرب بالقصص والأحاديث حتى الصباح، فنزل إلى ديوان الحكم ولم يضطجع معها. وعندما تأكّدت الجازية من عبور بني هلال هربت والتحقت بهم. ولما فشل السيف في فتح أبواب مدينة تونس تنكّرت الجازية مع مائة من فتيات بني هلال بمظهر بائعات متجولات، وتنكر معهم أبو زيد، ودخلوا المدينة المسوّرة، ومن ثم فتحوا أبوابها. وعندما استأثر دياب بن غانم بالسلطة والغنائم تزعمت الجازية الأيتام من بني هلال الذين شتتهم وقتلهم دياب بن غانم حتى كبروا وقوي عودهم، فقادتهم للدفاع عن حقوقهم متنكّرة بزي فارس حتى ماتت في سبيل الحق والحرية.
قلنا بداية بأنّ للجازية ربع أو ثلث المشورة، لأنّ رأيها عبر السيرة كان هو من يحسم توجّهات القبيلة، فقد كانت بوصلتهم التي لا تخطئ.
*****
لم تكن المرأة العربية في السّيَر الشعبية إلّا حجر العقد في المجتمع، والتي من دونها سينهار القوس الذي يقوم عليه، هكذا نجدها فاعلة بشدّة في سيرة علي الزيبق ممثلة بأمّه، بالإضافة إلى زينب ودليلة المحتالة التي تسنّمت مقدمية بغداد. لقد أبانت السّيَر الشعبية عن جوهرية المرأة في المجتمع العربي على عكس الثقافة الرسمية، أسواء كان الأمر مع شهرزاد التي روّضت الوحش في الذكر، أو مع ذات الهمّة التي عبر شجاعتها وتقواها وإيمانها استطاعت أن تفتح معقل البيزنطيين، أو مع عبلة التي خلقت من عشقها فارس الزمان عنترة، أو مع الجازية التي كانت بيضة المشورة وسداد الرأي.
*كاتب من سورية.

May 16, 2024
“الجماليات”: من مُثل أفلاطون إلى مجفّف الشَّعر لدى دوشامب
باسم سليمان16 مايو 2024
لقد صُكّ مصطلح (إستطيقا/ الجماليات) من قبل الفيلسوف بومجارتن عام 1735، حيث عرّفها بأنّها: “العلم بنمط المعرفة الحسّية بالموضوع” بينما حدّدها هيغل بـــ:”فلسفة الفنّ”. وإذا عُدنا إلى تعريفها بمعجم لالَند (المعجم التاريخي والنقدي للفلسفة) بأنّها: “العلم الذي يتخذ من أحكام القيمة التي نميّز بموجبها بين الجميل والقبيح موضوعًا له” نكتشف أنّ تعاريفها وموضوعاتها تختلف وتتنوّع! تعود كلمة إستطيقا إلى اليونانية، وهي مشتقة من كلمة (aisthesis) والتي تدل على ملكة وفعل الإدراك الحسّي. وهذا يعني بأنّها تختصّ بمملكة المحسوسات التي تقابل مملكة العقليات. ومن هنا تتساءل الفيلسوفة كارول تالون هيغون في كتابها: (الجماليات؛ ترجمه: د. عبد الهادي مفتاح وصدر عن دار 7 لعام 2023 ) أمام هذه التعاريف والمواضيع المختلفة للجماليات؛ هل هي نقد للذوق، أم هي نظرية في الجميل، أم هي علم الإدراك الحسي، أم هي فلسفة الفنّ؟ فتقول بأنّه أمام هذا التضارب بالتعاريف والمعاني تنبثق نقطتان؛ الأولى: بأنّ الجماليات هي بمثابة تفكير بموضوعات تهيمن عليها مصطلحات من قبيل: الجميل والمحسوس والفنّ. ولكن الثيمات الجمالية ليست ثابته، فمفهوم الذوق والذي اعتبر معيارًا حاكمًا للجماليات في القرن الثامن عشر تم إغفاله فيما بعد. والنقطة الثانية، بأنّ مقاربة الجماليات من خلال مواضيعها وخاصة الفنّ الذي يعتبر مجالًا لعلوم أخرى قد ظهرت في الوقت نفسه – في القرن الثامن عشر- كالنقد الفنّي وتاريخ الفنون وفيما بعد سيسولوجيا الفنّ، سيضيّق من مجالها. وقد رأى بعض المفكّرين بأنّ هذا الاشتراك مع الجماليات في مواضيعها من قبل علوم أخرى، وخاصة في مجال الفنّ سيؤدي إلى انحلالها.
وبناءً على ما سبق، تقترح هيغون أن تُعدّ الجماليات تخصّص فلسفي؛ وذلك لتمييزها عن تاريخ النقد وتاريخ الفنّ، وذلك لأنّ الجماليات هي طريقة في المناقشة والحجاج والتحليل. وإذا كان الفيلسوف بومجارتن قد صكّ المصطلح، فالجماليات سابقة عليه؛ ومن هذا المنطلق يجب إدراج أفكار أفلاطون عن الجميل في محاورته (هيبياس الكبرى) وكتاب (فنّ الشعر) لأرسطو و(تاسوعات) أفلوطين. وتشرح هيغون فكرتها بأنّ (الميتافيزيقا/ مابعد الطبيعة) هي تسمية أطلقها تلامذة أرسطو على أعماله التي تلت ( الفيزيق/ الطبيعة) فأرسطو لم يصكّ مصطلح الميتافيزيق، لكنّ أفكاره هي من أوحت لتلامذته بتلك التسمية. والغاية من تلك المقارنة إذا كان التأريخ لظهور مصطلح الجماليات سهلًا جدًا، فالأمر ليس كذلك لتعيين أولى المحاولات لضم مواضيع الجماليات من المحسوس والجميل والفنّ في تخصّص واحد. وهنا تعود هيغون إلى طرحها بأنّ الجماليات هي مسألة فلسفية نُوقشت عبر الأزمنة، لكنّها لم تمتلك المصطلح إلّا في القرن الثامن عشر، حينما اكتمل الحقل المعرفي لها. والذي يؤكّد ذلك بأنّ كانط صاحب أطروحة (نقد مملكة الحكم) والتي تعتبر من أهم الطروحات في الجماليات لم يستخدم المصطلح إلّا مرة واحدة، مع أنّ كتابه صدر عام 1890 وذلك بعد بومجارتن بالعديد من السنوات.
لكن لنعد لموضوعة التعريفات، يقول باسكال : “بأنّ التعريفات لم توضع إلّا لتعيين الأشياء التي سميناها، لا لتوضّح طبيعتها”. وإذا أخذنا نظرة الفيلسوف فيتجنشتاين، فإنّ كلمة جماليات هي “مفهوم مفتوح” أي أنّ معناها هو مجموعة توظيفاتها عبر التاريخ ومن هذه النقطة تنطلق هيغون!
ما قبل الجماليات:
كان أفلاطون من أوائل الفلاسفة الذين قاربوا موضوعة الجميل، ورأى بأنّ الجميل يجب أن يكون نافعًا وخيّرًا؛ وبالتالي أصبح الجمال المفتقد للمنفعة وللخير ليس جميلًا. وبعد ذلك يقرّر أفلاطون على لسان سقراط بأنّ الجميل: “هو ما تكون به الأشياء الجميلة جميلة”. ومن ثم يطوّر أفلاطون فكرته مع الفيلسوفة (ديوتيما) في محاورة المأدبة، وبأنّ الجماليات الحسّية هي المنطلق للوصول للجماليات العقلية. وفي النهاية أخرج أفلاطون كل الجماليات الحسّية من دائرة الجميل، حيث الأفكار الخالدة كالحق والخير والحقيقة هي الجميلة فقط. أمّا أفلوطين فقد أدخل الجمال المحسوس إلى دائرة الجميل، لكن استنادًا لأفلاطون واعتبر بأنّ الأفكار المثالية هي من تعطي شكلًا جميلًا للمادة وتنسِّق بين أجزائها، فتجعلها وحدة تامة: “فالكائن الجميل هو الذي تناسبت أجزاؤه وتناسق بعضه مع كلّه… لكونه ارتقى إلى الوحدة… أمّا الكائن القبيح فهو ليس مؤتلفًا في وحدة تامة، لأنّ مادته لم تنصع للأفكار المثالية. ويكمل أفلوطين بأنّ الإنسان يدرك الجماليات عبر صدّه عن المحسوس وإغماض عينه الشحمية عن الرؤية، لتنفتح عينه الباطنية: “فليصر إذن، كل شيء أولًا مقدسًا وجميلًا، إذا ما أردنا أن نتأمل الله والجميل”. وفي العصر الوسيط المسيحي، فقد كان الجمال حقيقة عقلية وبهاء ميتافيزيقيًا وانسجامًا أخلاقيًا. فالجميل في العصر القديم والعصر الوسيط، كما رأينا لم يكن شيئًا محسوسًا والأشياء المحسوسة لم يكن يقال عنها جميلة إلّا لأنّها انعكاس لعالم المثل.
فكّر القدماء بالفنّ وقد كانت كلمة (الفنّ/ art) تعني لديهم المهارة والدِّقة وتحيل إلى الرسم والنحت بقدر ما تتعلّق بأعمال السكافة والجزارة، فالفنّ لديهم مرتبط بالحرف والمهن ولا شأن للإبداع فيه. وهو وإن كان يحاكي الطبيعة إلّا أنّه أقل شأنًا منها. ولكن هذا لا يعني أنّهم لم يبدعوا أعمالًا فنية رائعة، فكما يقول أندريه مالرو عن فنون النحت والأيقونات في كتابه (تحولات الآلهة): “لقد أبدعها فنانون لم تكن فكرة الفنّ موجودة بالنسبة لهم”.
أدان أفلاطون الفنون وخاصة الرسم والشعر، فالنجارة أعلى شأنًا من الرسم، لأنّ النجّار وهو يصنع سريرًا، إنّما يحاكي فكرة السرير، أي نموذجه الأول والأزلي، بينما الرسام عندما يرسم سريرًا فهو يحاكي السرير المحسوس؛ وهذا أبعد عن الحقيقة. أمّا أرسطو فقد خالف معلّمه ورأى بالفنّ نشاطًا يستهدف غاية خارجية لا تتعلّق بالاستعمال والمنفعة. فالمحاكاة لدى أرسطو تسمح بميلاد موضوع جديد، فالتراجيديا توقظ فينا الشعور بالرأفة وبالرعب، إنّها تحيي فينا نوعًا من التطهير. لقد رأى أرسطو بالتراجيديا منافع إيجابية في السياسة وتخليص الناس من انفعالاتهم. لقد كان القدماء يرون بالجميل والفن نقلًا محسوسًا لِما هو حقيقي، لذلك كان على الفلسفة أن تذهب إلى ماهو حقيقي وتهمل الثانوي/ المحسوس. وبما أنّ الجماليات تفكير بالجميل المحسوس والفنّ، فلقد كان التفكير الميتافيزيقي يمنع ولادتها. لكن ما تكلمنا عنه سابقًا يعتبر الإرهاصات الأولى لفلسفة الجماليات التي ستنطلق في القرن الثامن عشر عندما توفّرت الظروف المناسبة.
ولادة الجماليات:
أنتج التطوّر العلمي والمعرفي في القرن الثامن عشر تغييرًا بالكيفية التي يُنظر بها إلى العالم المحسوس، فلم يعد مجرد محاكاة أو انعكاس مشوّه لعالم المثل والأفكار. ومن هذه الرؤية أصبح للمحسوس مجال تفكير خاص به، كان كانط قد نظّر له في كتابه (نقد العقل الخالص). وبناء على ذلك أصبح الجميل المحسوس ليس مجرد خاصية من خاصيات الموضوع ولا انعكاسًا لصدى الفكرة المعقولة عن الجمال؛ بل أصبح كيفية من كيفيات العلاقة التي تنشأ بين الذات والموضوع.
لقد صكّ بومجارتن مصطلح إستطيقا في كتابه (تأملات فلسفية في موضوعات لها صلة بماهية القصيدة) حيث اعتبر بومجارتن المحسوس متميز بمحتواه وليس شكلًا حسيًا لما هو معقول، وإن كان المحسوس الجميل أقل درجة من المعقول الجمالي، فهذا لا يعني أن يهمله الفيلسوف. وهذا ما نلحظه لدى كانط الذي رفض بداية أن يعتبرالجماليات مبحثًا فلسفيًا، لكنه تراجع عن ذلك في كتابه (نقد ملكة الحكم).
لقد أدّى ما سبق إلى أن تصبح الجماليات خطابًا للفن والجميل والمحسوس. ومن ثم جاءت النزعة الرومنسية التي ذهبت بهذا التصور الفلسفي للجماليات إلى أبعد مدى. لقد أكّدت الرومنسية على أنّ الفن ليس مجرد نشاط منتج أو زينة أو لعب، بل هو معرفة. ومن هنا أصبح الفن النبع الذي تنبثق منه الفلسفة. هذا التصور الرومنسي يأخذ مداه مع هيغل الذي يقصي من الجماليات دلالة المحسوس الذي استمدتها من أصلها اللغوي وتنظير بومجارتن، ويحصرها بالفن، لأنّ الفنّ لديه هو التجلي للروح الكونية، وكأنّ هيغل أعاد للميتافيزيق وجوده، لكن بصياغة أخرى تتفق مع فلسفته.
كما أكّد فيتجنشتاين بأنّ الجماليات مفهوم مفتوح على استخدامات الكلمة؛ نجد الفيلسوف شوبنهاور في كتابه (العالم إرادة وتمثل) بأنّ الكون عبارة عن إرادة تكون عمياء على مستوى المادة، وشبه واعية على مستوى الحيوان، وواعية تمامًا عند الإنسان، ومع ذلك هو محكوم بحتميتها، حيث يساعده الفنّ على الخروج من نهر هذه القوة العمياء للكون وتأمّلها، ممّا يجعله حرًا على الرغم من القدرية التي تسوقه نحو الفناء. إذن فالفنّ عند شوبنهاور خضوع متأمّل لإرادة الكون لكنّه حرّ. أمّا نيتشه فقد أراد من الفنان أن يكون فيلسوفًا، ليكون قادرًا على بث روح التجديد في المجتمع.
على الرغم من اختلاف وجهات نظر المفكرين والفلاسفة الذين نظّروا للجماليات، إلّا أنّ هناك وحدة تجمعهم؛ وهي اعتبارهم للجماليات بأنّها فلسفة الفنّ. وللفنّ بعده الوجودي بوصفه وسيلة لمعرفة من نوع خاص، أسمى من المعرفة العادية. وهذا الأمر يفسّر سرّ انجذاب الفلسفة إلى الفنّ؛ ذلك أنّ الفنّ ينحو نحو الفلسفة والفلسفة تتجه نحو الفنّ كمجال لمعرفة سامية.
الجماليات وتحديات القرن العشرين:
عندما ظهرت أساليب الفن الحديثة من الانطباعية إلى السريالية والتكعيبية أصبحت الأساسيات التي يقوم عليها الفنّ عرضة لتساؤلات كثيرة من مثل: ماهو العمل الفنّي، وما هو نوعه وأخيرًا ماهو الفنّ؟ حتى إنّ المفكِّر (هارولد روزنبرغ) أطلق على هذه المرحلة في بدايات القرن العشرين: “الفنّ دون تعريف”. لقد كفّ الجميل أن يكون هاجسًا للفنّ، فمع الرومنسية أصبح القبح حقلًا تهدف الجماليات لاستكشافه. ومع الانطباعية غدا العادي واليومي والمبتذل كلوحة (الأرصفة المبتلّة) لرنوار مقصدًا. هذه المذاهب الفنية الجديدة ذهبت إلى حدّ نزع الجمال عن الجميل وجودته الجمالية ومحسوسيته، فلقد صرح النحّات (روبيرت موريس) عن بنائه الفني المعدني المسمى:(ليتاني) بمايلي: “أشهد أنا الموقّع أسفله روبيرت موريس… بتجريده من خاصيته الجمالية ومحتواه”. وقد علّق الرسام دوشامب الذي جعل من (المبولة، ومجرفة الثلج، ومجفّف الشعر) مواضيع فنية، على الذين اعتبروا بأنّه يُظهر البعد الجمالي في الأشياء التي يقال عنها سخيفة وبلا معنى، بأنّ هذه الأشياء قد أوحت له بالعكس، أي إخراجها من دائرة الجميل والمعنى، لكنّها أعمال فنيّة.
ذهب الفيلسوف والتر بنيامين في كتابه: (العمل الفنّي في عصر استنساخه التقني) إلى أنّ تسجيل الموسيقى على أسطوانات ونسخ اللوحات العظيمة في صور أدّى إلى شيوع العمل الفني ونزع القداسة عنه، فالتأمّل والاهتمام الجاد، الذي كان العمل الفني يحظى به في الماضي، قد تحوّل إلى اهتمام مشوب بالاسترخاء، ممّا أدّى إلى فقدان الهالة التي كان يُحاط بها العمل الفني. أمّا تيودور أودرنو من مدرسة فرانكفورت النقدية فقد لحظ أنّ الفنّ والجميل والمحسوس قد سُيطر عليهم من قبل الرأسمالية، فلم يعد يهم الإبداع بقدر العرض؛ مادام السوق هو الحاكم. لذلك كان يرى بأنّ للفن دورًا نقديًا يجب أن يقوم به.
لقد رُبطت الجماليات بالمثل الأفلاطونية، وبالمقدس، ومن ثم باليومي والعابر إلى اللامعنى. وهذه كلها حقول تستكشفها الجماليات في تحليلها ونقدها وفي تطلّعها إلى عالم يسوده الجميل. وبعد أن قدّمت هيغون في كتابها عرضًا تحليليًا للجماليات، من لحظة صكّ المصطلح، إلى الإرهاصات الأولى في العصر اليوناني، إلى أن استبعدت الجماليات أهم ما يميز الفن وخاصة ارتباطه بالجميل والمحسوس من حقل الجماليات؛ تتساءل في نهاية كتابها عن مستقبل الجماليات، استنادًا إلى مقولة والتر بنيامين: “إنّ اختلاف الأشكال التي اتخذتها المجتمعات الإنسانية عبر المراحل التاريخية الكبرى، قد كان مصحوبًا كذلك بتحوّل في كيفية إحساسها وإدراكها” تاركةً الجواب معلّقًا ومفتوحًا على المستقبل، وما يطرحه من أنواع عديدة للواقع وللجماليات التي تحايثه، أسواء كان الأمر في الواقع الحقيقي، أم في الواقع المعزّز، أم في الافتراضي؟
باسم سليمان
كاتب سوري
خاص ضفة ثالثة

May 11, 2024
باسم سليمان يلاحق «فراشاته البيضاء» رولا حسن – جريدة الأخبار اللبنانية
انعكست العلاقة الوثيقة بين الإنسان العربي وحيوانات بيئته على عالمه النفسي، كما تجلت في إرثه الثقافي المتنوع منذ مدة مبكرة من تاريخه. التوسل بلسان الحيوان، ليس بالفن الجديد على الثقافة العربية، ولم يكن كتاب «كليلة ودمنة» أول عهده بها، وقد بلغ هذا الفن ذروة سامقة في توظيف رمز الحيوان في السياقات الإنسانية المختلفة ومحاكاة قيمته الرمزية المتولدة عن تشاكله مع عالم الإنسان، ما منح المبدع إمكانات تعبيرية أرحب لتحقيق المقاصد المختلفة، فالسرد القصصي على لسان الحيوان من أقدم الأنواع القصصية الموجودة في التراث القصصي العربي التي تعزو الأفعال والأقوال إلى الحيوان بمقاصد كثيرة، اجتماعية وسياسية وثقافية تنتقد الوضع القائم، محمّلةً بمواقف وتصورات كشفت أبنية الفكر السياسي، وجدلياته مع ما يحدث في الواقع السياسي والثقافي تحت إطار نصوص سردية قصصية على لسان الحيوان، تمتزج فيها الحقيقة بالوهم، والجدّ بالهزل، والواقع بالخيال.
من هنا يمكن قراءة باسم سليمان في مجموعته القصصية «فراشات بيضاء» (دار ميسلون) وفهم ميله إلى الانجذاب نحو الأبطال غير البشريين، إذ يجعلنا نستعيد حكايا الجدات في حكاياته الصغيرة والغريبة، وأجوائها وتكشفاتها المفاجئة ورؤيتها المتبصرة. في حكايات سليمان التي تتناول المخلوقات ومصائرها، تتشوّش الحدود بين الذات والموضوع، وبين الحي والجماد، وتفضح دعوى التفوق كأن هذه الحكايات تقرّ بقوة الأسئلة بدلاً من الإجابات.
هنا لا يمكننا إلا أن نتذكر كتاب «كليلة ودمنة» الذي صدر في القرن الرابع الميلادي، سارداً حكاياته على لسان الحيوانات عبر سلسلة من القصص التخيلية والأسطورية التي تتناول أكثر من موضوع، وأهمها علاقة الملك بشعبه وبعض المواعظ الشعبية والحكمة السياسية، فماذا أراد باسم من هذا التناص أو المحاكاة؟
عبر قصصه القصيرة، يجتهد صاحب «جريمة في مسرح القباني» في طرح قضايا معاصرة، ولكن بلسان الحيوانات والحشرات والطيور. هل لأنّه ما من طريقة أخرى لقول كل ما أراد قوله أو بعبارة أخرى ما أراد إيصاله؟ لم يعطِ سليمان البطولة للبشرية التي تقتتل على الأرض وتقاتل من أجل السلطة والمال بل أعطاه لكائنات صغيرة وبريئة. وكما يوضح باسم، فإنّ القصص في «فراشات بيضاء» هي أنسنة مضادة أو لنقل إنّ القاص الإنسان تنحّى جانباً وترك الكائنات الحية تقصّ تجربتها الخاصة، فالدجاجة تكسر بيضتها في قصة «وسكتت عن الكلام المباح» احتجاجاً على جدال الفلاحين السفسطائي كأنها شهرزاد التي ترفض الاستمرار في ترويض شهريار الإنسان ولو كان السياف/ الثعلب مسروراً بالقضاء عليها.
حاول باسم تحويل المقولات الشعبية إلى حكايات غير عادية لها كثير من الإيحاءات والدلالات، موقظاً القارئ من استرخائه اللذيذ بحسب مالارميه عبر إستراتيجية سردية، شارحاً كيفية استنباط هذه الدلالات التي تتشعب على قسمين: الأول بقراءتها في زمن قولها، أي العودة إلى تاريخ القول وبيئته الثقافية التي تفتح مغاليقه، والثاني استجرارها إلى عصرنا لتنطبق مع آنية أفكارنا.
يمكن القول هنا إنّ سليمان يلعب لعبة الدلالة والإيحاء بذكاء، فالحكاية حكايتنا وليست حكايتنا، وبين «البين بين» يبني سليمان نصه القصير على كثرة الإحالات وتوالي الإشارات المعرفية في النص السردي، فيحتشد بتداخل الثقافات، وبالتالي تداخل الإشارات. ففي قصته «قائمة طعام»، كانت قناعة الحمل الثائر على المرياع بأن الخطر الوحيد الذي يهدد الخراف هو الذئاب، لكن عندما هرب من الحظيرة إلى الغابة، وجد النمر يأكل الخراف. وهنا ترتج ثقافة الحمل الثائر على تقاليد الخراف، لكن هذه المعرفة الجديدة لم تؤتِ ثمارها لأن النمر كان قد التهمه. إن بنية القصص عند سليمان تتجاوز في رأيه التعريف النقدي للقصة بأنها تكثيف لحدث معين منتقى كشريحة من نهر الأحداث، بل إنّ بنية القص في المجموعة تقوم على العكس من ذلك بمدّ لحظة الحدث الكثيفة والموجزة كما يفعل الرسام مع اللون لتغطية مساحة معينة في اللوحة. من هنا جاءت القصص كضربات ريشة تعبيراً عن لاإمكانية قولها إلا بتلك الطريقة كضربة سكين بحسب تعبيره.
يستخدم سليمان ضمير الشخص الثالث أو ضمير «الهو»، فهو يسمح للقارئ بأن يلتحم بعالم النص، ليقدّم رؤية مغايرة عن رؤية الآخرين وتبقى هوية السارد مختفية، ما يساعد على تأكيد القول القصصي أو تثبيت الأفكار المختلفة داخل النص وهذا الضمير مرتبط بالحكاية منذ ولادتها.
يتميز السرد عند سليمان بالتكثيف من دون مماطلة للوصول إلى ما يريد قوله، حيث امتاز بتعدد حقوله الدلالية وبإثارته للتأويلات المختلفة لدى القارئ حتى يكاد يصبح شريكاً في إنجاز النص. أفاد سليمان من مهارته في اللعب على الشكل والبناء والتكثيف واختزال الحدث المحكي مستغلاً مهارته اللغوية في القص، وهذه الأطر مجتمعة مكّنته من فتح فضاءات دلالية جديدة متنوعة عبر اللعب على الإيحاءات والرموز التي تمثلها الشخصيات، وبالتالي اللعب على الفضاء الافتراضي الذي تمنحه إياه اللغة، إضافة إلى الإحالات التناصية التي تفتح مسارات واسعة للتأويل.
بكثير من الحذق والهندسة والكثافة والاقتصاد والتركيز في اللغة والحوار والفكرة والصورة القصصية، يقدم باسم سليمان فراشاته البيضاء، وهو يطرح قضايا الإنسان المعاصر شؤونه وشجونه مؤنسناً عناصر الطبيعة البكر لتنطق بما لا نجرؤ على قوله وتحتج على ما لا نستطيع الاحتجاج عليه عبر قصة تشبه الحكاية، وحكاية هي قصتنا جميعاً. https://al-akhbar.com/Kalimat/381728/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9-%D8%B3%D9%D9%8A%D9%D8%A7%D9-%D9%8A%D9%D8%A7%D8%AD%D9-%D9%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA%D9-%D8%A7%D9%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1

May 6, 2024
ماذا يحدث لو اندلعت “حرب أهلية” بأقوى دولة بالعالم؟
باسم سليمان 6 مايو 2024 – مقالي في ضفة ثالثة
يمتلك الفنّ قدرةً على التنبّؤ، ليس لأنّه عرّاف، بل لجرأته الكبيرة على التجريب واجتراح واقع موازٍ يختبر به الواقع الحقيقي. من هذا المنحى الرؤيوي التحذيري ينطلق المخرج وكاتب السيناريو أليكس غارلاند في سرديته السينمائية (حرب أهلية/ Civil War لعام 2024) مستطلعًا فرضية قيام حرب أمريكية أهلية يعود سببها المباشر لاستئثار أحد الرؤساء الأمريكيين بولاية ثالثة وإعطائه الأوامر العسكرية لقصف المدنيين المحتجّين على مخالفته الدستور، ممّا يؤدي إلى انفصال ولايتي تكساس المحافظة وكاليفورنيا الليبرالية وإنشائهما جبهة موحّدة تحارب هذا الديكتاتور الجديد الذي وصل إلى البيت الأبيض عبر الديمقراطية. لم يكن اختيار غارلاند هاتين الولايتين لأنّهما عادة ما يكون موقفهما حاسمًا في دعم المرشحين المتنافسين في السباق إلى البيت الأبيض، وإنّما لكونهما أيضًا تشكّلان القوة الاقتصادية والتجارية الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية وما يؤشّر له ذلك من قدرتهما على الاستقلال والانفصال. وفي خلفية هذا الواقع المفترض تظهر الأحداث السياسية الواقعية التي جرت في عام 2021 كسبب غير مباشر، لهكذا تنبؤ؛ وذلك عندما اقتحم الكونغرس الأمريكي مجموعة من المحتجّين والداعمين للرئيس السابق ترامب من أجل قلب نتائج الانتخابات التي فاز بها الرئيس الحالي بايدن. ويضاف إلى هذه المرجعيات الخيالية والواقعية التي طُرحت في الفيلم تهديد ولاية تكساس في عام 2024 بالانفصال نتيجة التعارض بينها وبين سياسة البيت الأبيض حول مسألة المهاجرين، فكانت خير دعاية مؤثرة للفيلم، فهي تدلّ على وجود الجمر تحت الرماد، وإن لم تكن هذه الحادثة الأخيرة ضمن حسبان مخرج الفيلم، إلّا أنّها على مهمّة صعيد المشاهد، فلا يمكن غضّ النظر عنها. هذه الحيثيات جعلت من فيلم غارلاد (حرب أهلية) يتصدّر شباك التذاكر في أمريكا محققًا أرباحًا في أسابيعه الأولى تجاوزت تكلفته التي قدرت بخمسين مليون دولار. وهذا الأمر ليس غريبًا لأنّ الفيلم لامس هواجس المشاهد الأمريكي وفضول المشاهد العالمي؛ ماذا سيحدث لو اندلعت حرب أهلية في أقوى دولة في الكرة الأرضية؟
يفتتح غارلاند أولى مشاهده بالرئيس الأمريكي وهو يحضّر نفسه لإلقاء خطاب النصر، حيث يقف أمام المرآة مرددًا العبارات الحاسمة التي ستصبح تاريخية. ثم ينتقل إلى مشاهد قمع الشرطة للمدنيين حيث تقوم المصوّرة لِيْ (كريستين دانست) بتوثيق العنف من قبل الشرطة بحقّ المدنيين بعدستها مرتدية سترة مكتوب عليها (صحافة). وفي خضم هذا العنف تدخل الشابة جيسي (كايلي سبيني) دائرة العنف لتقوم بالتصوير، فتمنحها لي سترة الصحافة وتطلب منها الابتعاد اعتقادًا من لِيْ بأنّ هذه السترة مازال لها حصانتها. تنفجر إحدى السيارات وتهرع الصحفيتان للاختباء خلف إحدى سيارات الشرطة! لم تكن حماية لِيْ لجيسي من انفجار السيارة هو ما سيقدح شرارة علاقة الصداقة بينهما، وإنّما حلم جيسي أن تمشي على خطى لِيْ كمصورة حربية، فهي مثالها الأعلى واسمها موجود في موسوعة الويكيبيديا.
بعد أن شيّد غارلاند ضلعي مثلثه ليدخلنا في أجواء الحرب الأهلية الأمريكية، كان لا بدّ له لكي ينجو من التجاذبات السياسية في الحاضر الأمريكي والتأويلات المختلفة والاتهامات المتبادلة بين الأطراف المتنافسة في السباق إلى البيت الأبيض، ممّا يحرف فيلمه عن هدفه، أن يذهب بقصته/ الضلع الثالث، منحى آخر، أو وفق تعبير لي كمصورة حربية، بأنّ واجبها أن تنقل الصورة من دون تحيّز. ومن هنا كانت قصة الفيلم التي تقوم على رصد معاناة وتضحية مجموعة من الصحفيين لنقل صورة الحقيقة خلال رحلتهم إلى البيت الأبيض لإجراء مقابلة مع الرئيس قبل أن تصل إليه القوات العسكرية من الولايات المعارضة له. فليس غريبًا أن تكون رغبة هؤلاء الصحفيين تسجيل الكلمات الأخيرة لرئيس مغتصبٍ للسلطة، فما يريده غارلاند بأنّ الحق بالوصول إلى الحقيقة وإلى جميع الأطراف المتصارعة، هو ما يسمح بأن يُنزع فتيل حربٍ- لربما ليست مفترضة.
الجندي الأمريكي:
اعتاد المشاهد الأمريكي والعالمي أن يرى الجندي الأمريكي وهو يخوض المعارك خارج بلاده، بدءًا من الحربين العالميتين وصولًا لزمننا الحاضر، حتى لُقب بشرطي العالم! فلم تتم رؤيته يقاتل على أرضه الأمريكية دفاعًا عنها إلّا تخيّلًا وضد عدو خارجي؛ أكان الاتحاد السوفيتي سابقًا أو كوريا الشمالية حاليًا، كما في فيلم (سقوط البيت الأبيض/ Olympus Has Fallen). لكن مع غارلاند فقد تم وضع الجندي الأمريكي في مقابل الجندي الأمريكي على الأرض الأمريكية مذكرًا بالحرب الأهلية في القرن التاسع عشر. وكأنّه يقول، إذا كانت تلك الحرب سببًا في نشوء أمريكا كما نعرفها حاليًا، فقد تكون الحرب القادمة سببًا في زوالها. إنّ استحضار ثيمة الجندي، ليس فقط من أجل بث مخاوف النبوءة التي يحملها الفيلم بين طياته، بل إعادة لتفعيل شخصية الجندي البطل، أسواء كان مع فرانسيس كوبولا في فيلمه (القيامة الآن/Apocalypse Now) الذي يصوّر التشوّهات النفسية والفكرية نتيجة الحرب مرورًا بـ(رامبو) سلفستر ستالوني من أجل إيقاظ فرادة الجندي الأمريكي الذي يقف بوجه الطغيان إلى (إنقاذ الجندي رايان) لسبيلبرغ كتمثيل للتضحية. من هذه القاعدة يصوّر لنا غارلاند حجم الدمار الذي سببته الحرب وفي الوقت نفسه يترك المشاهد ليتساءل: هل ستتغوّل القوّات العسكرية الانشقاقية التي تتّجه إلى البيت الأبيض لإعادة الأمور إلى نصابها؟ وبدلًا من حاكم ديكتاتوري سنكون مع مؤسسة عسكرية تحكم البلاد بالقوة والنار؟ هي أسئلة تركها غارلاند مبهمة، فالمشاهد العسكرية كانت قليلة لعنوان هكذا فيلم، إلّا في اللحظات الأخيرة عند سقوط حامية البيت الأبيض وبدء البحث عن الرئيس لقتله!
لا شيء يحدث في أمريكا:
تُذكرنا هذه العبارة برواية: “لا شيء يحدث على الجبهة الغربية” للروائي الألماني إريش ماريا ريماك والتي اقتبست أكثر من مرّة للسينما. ومدار التهكّم الذي يقصده غارلاند يكمن في تلك الإجابات التي كان الأهل يدّعونها أمام أولادهم، عندما يتم الكلام عن الحرب الأهلية. فالصحفية جيسي تقول لِلِيْ، بأنّ والديها يدعيان بأنّه لا شيء يحدث! كما كان المراقب للجبهة الغربية بين فرنسا وألمانيا في الحرب العالمية الأولى يستطيع أن يقول، بأنّ لا شيء يحدث هناك، فلم تتقدّم القوات الألمانية ولا الفرنسية شبرًا واحدًا، بل ظلّا يراوحان في مكانهما على الأرض، بينما آلة الحرب تأكل الجنود وتلفظهم موتى بأعداد هائلة. وهذا الإنكار، هو ما كانت تصادفه فرقة الصحفيين وهي تعبر الولايات المختلفة إلى البيت الأبيض، فالطرقات مدمّرة ومملوءة بالسيارات المحترقة والأفق ترسمه انفجارات القنابل والحرائق، فيما يتبجّح الجيل القديم من الأمريكان، بأنّه لا شيء يحدث! وعندما تدخل الفرقة الصحفية إلى إحدى المدن التي لم تفتك بها الحرب بعد، يجدون أهلها مازلوا يعيشون بهدوء، كأنّه حقًا، لا شيء يحدث، لكن على أسطح البنايات كان هناك من يراقب عدم انكشاف زيف هذه اللامبالاة. من هذه المفارقة التي عاينتها فرقة الصحفيين، وسيلاحظها المشاهد بأنّ استخدام أسلوب النعامة لم يمنع الحرب عندما اكتملت شروطها بالصمت على ما يحدث من انتهاكات في أمريكا. فعلى أرض الواقع نرى كيف شُكلت العصابات نتيجة انهيار الدولة، فالدولة وفق رؤية المفكّر (تيري إيغلتون) تقوم على إدارة وضبط النزاع في المحتمع، وعندما تنهار ينفلت الصراع المجتمعي من عقاله وتحدث الحرب الأهلية. ففي محطة للوقود نكتشف أنّ الدولار لا قيمة له، ولا يكون دفع الثمن إلّا بالدولار الكندي وقد قام أصحاب المحطة الذين يمتلكون الأسلحة بتعذيب جيرانهم، ومن ثم إعدامهم لأنّهم أرادوا سرقة الوقود. وفي حادث آخر نستشعر وجود قناص يطلق النار، ولكنّه غير معروف الانتماء. وعندما يسأل المراسل جويل (واغنر مورا) أحد المزارعين الذي يقعي خلف عدسة بارودته عن هوية القناص فيجيبه، بأنّ الأمر ليس مهمًا، فمادام يريد قتلنا، سنقتله. تتقدّم فرقة الصحفيين نحو البيت الأبيض ليقعوا بين يدي عصابة بيضاء تقوم بقتل المدنيين ودفنهم في حفر. وهنا تظهر العنصرية المبطّنة عند سؤال أفراد الفرقة عن مساقط رؤوسهم. ولولا جرأة الصحفي العجوز الأسود سامي(ستيفن هندرسون) الذي اندفع بالسيارة ليصدم أفراد العصابة، لكانت فرقة الصحفيين انتهت في إحدى المقابر الجماعية.
الرؤية بين جيلين:
ركّز الفيلم على التناقض القائم بين الأجيال في الولايات المتحدة الأمريكية، فكل من لِيْ وجيسي، قد نقلتا لنا مقولة أهليهما عن أنّه لا شيء يحدث. لكن في الوقت نفسه نرى لِيْ بوجه حزين وإرادة محبطة، وكأنّها لا تريد أن تصدِّق ما يحدث، فلم تكن صورها يومًا تنقل مآسي الحروب عن بلدها، والآن هذا ما يحدث! وفي لحظة بوح تقول، بأنّها مع كل صورة كانت ترسلها من ميادين الحروب الأخرى إلى وكالات الصحافة في بلدها كانت عبارة عن تحذير، فالذي حدث هناك، كل أسبابه متواجدة لدينا، فالحرب قاب قوسين أو أدنى من إطلاق أول رصاصة. هذا الواقع الجديد أجهض إرادة لِيْ، بينما نجد جيسي كشابة في مقتبل العمر على الرغم من الصدمات التي تلقتها في تلك الرحلة مندفعة في عملها، تواجه المخاطر بقلب جسور. وفي مشهد معبّر في البيت الأبيض تندفع جيسي غير مبالية بتبادل إطلاق النار لتلتقط الصور، فتصبح في مرمى الرصاصات، فتندفع لي لإبعادها لكنّها تسقط ميتة. وهنا تقوم جيسي بالتقاط الصور لمعلِّمتها القتيلة، فتضحيتها يجب أن تُخلّد. هكذا تجاوزت جيسي صدمتها وفجيعتها بموت مثالها الأعلى وأخذت تقوم بالتقاط الصور، فالحقيقة يجب أن تصل مهما كانت الأثمان. وكأنّ المخرج يريد أن يشير إلى أنّ الأجيال القديمة مسؤولة عمّا حدث، وما تضحية سامي ولي إلّا ضرورة حتمية حتى تستطيع الأجيال الجديدة الاستمرار.
حرب أهلية:
يُقبض على الرئيس، ويوجّه إليه ثلاثة جنود أسلحتهم أكثرهم من العرق الملوّن، فيما يسارع جويل طالبًا من الرئيس كلمة/ حكمة. لا يتلفّظ الرئيس بخطبة النصر التي تدرّب عليها أمام مرآته، بل بإحدى الوصايا العشر: “لا تقتل” لكن ما الذي كان الرئيس يفعله قبل ذلك؟ لقد أمر آلته الحربية بقتل المدنيين؛ والقاعدة الثأرية تنصّ على أنّ القاتل يُقتل. قد يبدو ظاهريًا أن مقولة الرئيس بـــ (لا تقتل) نوعًا من الاسترحام، لكنّ مكر غارلاند المتضمّن بالمشهد، بأنّ القوة العسكرية لا يجوز لها أن تحكم، فالأولى لإحقاق الدستور أن يُقاد الرئيس إلى المحاكمة لتعود الدولة إلى وظيفتها الأساسية بإدارة النزاع.
عندما كانت القوات المناوئة للرئيس الديكتاتور تحاصر البيت الأبيض وتحاول اقتحامه يصدح صوت باللغة العربية: “الله أكبر”! هذه الصرخة قد تم تشويهها كثيرًا في الميديا الغربية وفي الواقع عبر التنظيمات الإرهابية، إلّا أنّ غارلاند أرادها هنا دليلًا على غنى التنوّع وأن من يحمي الديمقراطية الغربية ليس العم سام فقط، بل تلك الشعوب المختلفة والمتنوعة التي جعلت من أمريكا أرض الحلم بالنسبة للبشرية.
قلنا بداية، بأنّ الفيلم اتخذ مسار تصوير معاناة الصحفيين، وهم ينقلون الأحداث والتضحيات التي يقدّمونها. ومن خلال مناقشة الفيلم ابتعدنا قدرًا لا بأس به، وكأنّنا نتكلّم عن فيلم آخر! هذه النقطة توضّح الإبداع الجميل لغارلاند؛ وذلك بأن تقول السياسة من دون سياسة، وأن تصوّر العنف بمقدار التضحية، وأن تظهر الاختلافات بين الأجيال من دون أن تمزق الجلباب القديم. هذا ما فعلته جيسي وهي تقنع لِيْ بأن ترتدي فستانًا بدلًا من ثوبها الميداني لتخطف لها ابتسامة تظهر في انعكاسها في المرآة، حيث كانت جيسي تتبدى خلفها وبيدها الكاميرا وكأنّها لِيْ في مقتبل العمر وفي بداية حياتها المهنيّة.
باسم سليمان
خاص ضفة ثالثة

May 3, 2024
إمبراطور الجسد: رحلة في تاريخ قلب الإنسان – مقالي في موقع قناة الميادين – باسم سليمان
تمتاز ملحمة جلجامش بأنّها قدّمت لنا أولى الملاحظات على اعتقاد الشعوب القديمة بأنّ القلب هو مركز الحياة في الجسد الإنساني، وبغياب نبضه يحدث الموت. تقرّر الآلهة موت إنكيدو بعدما قام مع جلجامش بقتل الثور السماوي وتقديم قلبه قرباناً للإله شمس. يموت إنكيدو، فيتلمّس الملك جلجامش صدره ليتيقن من موته: “وحين أضع يدي على قلبه، أجده لا ينبض”.
في القرن السابع عشر، أعلن الطبيب وليم هارفي بأنّ القلب مجرد مضخة للدماء، وليس مكانًا للنفس والأفكار والأحاسيس والمشاعر. يتتبع طبيب القلب فنسنت إم فيغيريدو في كتابه: “التاريخ العجيب للقلب؛ رحلة في الثقافة والعلم”، والصادر عن دار سبعة عام 2023 في القاهرة، تطور فهمنا للقلب منذ فجر الحضارة إلى الوقت الحاضر وأهميته في الفن والثقافة والدين والفلسفة والعلوم.
القلب في العصر القديماجتمع في القلب كلّ ما ننسبه الآن إلى الدماغ من أفكار وضمير ونفس وعواطف وأحاسيس، ففي الحضارة الفرعونية، اعتبر القلب الشاهد على أعمال الإنسان، فعندما يموت الإنسان يُوضع قلبه في كفّة ميزان، وفي الكفّة المقابلة ريشة نعامة، فإن ثقلت موازين القلب كان مصيره إلى الجحيم، وإن خفّت كان مصيره جنة الإله أوزوريس.
أمّا في الصين، فقد رأوا أنّ القلب ملك الأعضاء جميعها، ففيه يكمن الوعي والذكاء، وهو يتحكّم في كل أعضاء الجسد. وكما كان المصريون يعتقدون بأنّ القلب يتكلّم من خلال أطرافه/ الشرايين، ويعبر عن صحة أو مرض الجسد، فقد أشار الصينيون إلى أنّ الدم يتدفّق بشكل دائري في الجسد.
كان الإله ديونيسيوس ابناً للإله زيوس وبيرسفوني. وفي نوبة غيرة، أمرت هيرا زوجة زيوس المردةَ بأن يقتلوا الطفل. واستطاعت أثينا ابنة زيوس أن تنقذ قلب أخيها، فقام زيوس بطحن قلبه وسقاه مع شرابٍ لامرأة أرضية جميلة تُدعى سيميلي، فتكوّن ديونيسيوس من جديد في رحمها، لكنّها طلبت من زيوس أن تراه في جلاله الإلهي فاحترقت. وهنا، أنقذ زيوس الجنين وزرعه في فخذه حتى ولد. ومن خلال هذه الأسطورة، عبّر اليونانيون عن مركزية القلب في حياة الآلهة والبشر.
مع تقدّم الحضارة الإنسانية، بدأت أسئلةٌ تُطرح عن مكان وجود النفس والقدرات العقلية في الجسد البشري، وانقسم العلماء، فمنهم من أخذ بمركزية القلب، حيث توجد النفس والقدرات العقلية، ومنهم من اعتبر الدماغ المركز. اعتقد المصريون بأنّ الإله بتاح خلق العالم من قلبه، فيما كانت الروح في القلب لدى الصينيين.
أمّا الهنود، فقد كان الإله شيفا خالق الكون لديهم يُدعى سيد القلب، وتلقب زوجته بإلهة القلب. وبحسب ما جاء في الأسطورة الهندية، بعد انتصار الإله راما على إله الشّرّ، كافأت زوجته قائد جيشه بعقد من اللؤلؤ، فما كان من قائد الجيش هانومان إلّا أن رمى العقد. وعندما سُئل عن السبب، قال إنّه لم يجد في حبات اللؤلؤ الإله راما. وعند ذلك، فتح صدره ليجدوا صورة الإله راما مصوّرة في داخله.
كان الإله أبولو في الأسطورة الإغريقية إله العقل، فأخذ يسخر من كيوبيد صاحب القوس والسهم الذي يصيب به القلوب، فما كان من كيوبيد إلّا أن وجه سهماً ذهبياً إلى قلب أبولو فعشق حورية الماء دافني. وفي الوقت نفسه، وجه سهماً من حديد إلى قلب دافني، فكرهت الإله أبولو. شرع الإله بمطاردة محبوبته التي تكرهه من دون جدوى. هكذا، أثبت كيوبيد لإله العقل سطوة العواطف.
انقسم اليونانيون بين القلب والدماغ، وانحاز أبقراط أبو الطب إلى الدماغ واعتبره مركز الوعي ووافقه أفلاطون في ذلك، في حين ذهب أرسطو إلى مركزية القلب، إذ ذكر في كتابه “تاريخ الحيوانات” بعد مراقبة أجنّة الدجاج في البيض بأنّ الحياة تبدأ أولّاً في القلب. ليس غريباً أن يعتقد أرسطو بأنّ القلب هو مقرّ الوعي، فالعواطف القوية تسبِّب تسارع نبضات القلب. وقد تؤدي إلى الوفاة.
اعتبر جالينوس من أهم أطباء العالم القديم. وقد وافق أرسطو بأن القلب هو مركز الحياة، إلّا أنّه بعد دراسة أبي الطب أبقراط وأفلاطون، اعتمد جالينوس التقسيم الذي أوجده أفلاطون للقوى في الجسد الإنساني، فالنفس العقلانية موضعها في الدماغ، والنفس الروحية في القلب، والنفس الشهوانية في الكبد.
تأكّدت بعد ذلك أهمية القلب على العقل في الديانات التوحيدية، ففي اليهودية، يتكرّر ذكر القلب أكثر من 700 مرة، إذ اعتبر اليهود أنّ القلب مكان حضور الله في قلب المؤمن، فجاء في التوراة: “وأعطيهم قلباً ليعرفوني أنّني أنا الرب”. وفي المسيحية، يرى القديس بولس أنّ رسالة المسيح ليست مكتوبة على ألواح حجرية- كما في التوراة عندما عاد النبي موسى بالوصايا العشر من جبل سيناء- بل على ألواح لحمية في القلب. وورد ذكر القلب في القرآن الكريم 180 مرة: “أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ”، فالإسلام يرى القلوب التقية السليمة عقلانية. أمّا القلوب المريضة، فجاهلة.
تشريح القلبيقول الطبيب اليوناني أبقراط في القرن الرابع قبل الميلاد: “القلب عضلة في منتهى القوة”. كان الاعتقاد قديمًا بأنّ الأمراض عقوبات توقعها الآلهة على البشر، في حين أكّد أبقراط أنّ الأمراض تسبّبها الطبيعة، فقد كان من أتباع مركزية العقل لا القلب، وكان أول من أسّس مدرسة طبية.
يعد ألكمايون الكرتوني تلميذًا لفيثاغورث، وهو أول من شرّح الأجساد البشرية حيّة وميتة. وبالاستناد إلى دراسته التجريبة، قال إنّ العقل لا القلب هو مركز الوعي والأحاسيس. ومع هؤلاء الأطباء، بدأت الأوصاف التشريحية للقلب تظهر. وقد قال أرسطو إنّ القلب هو مركز الجهاز الوعائي الدموي في جسد الإنسان.
وفي العصر الهليني بعد الإسكندر المقدوني، تطوّر تشريح الأجساد كثيرًا، وخصوصاً في مصر في عهد البطالمة، إذ سمحت السلطة آنذاك بذلك. كان الطبيب هيروفيلوس أبًا لعلم التشريح، وعدّه عماد الدراسة الطبية لفهم الجسد البشري، وهو من اكتشف الجهاز العصبي، ووصف الشرايين والأوردة، ليؤكّد مقولة مركزية الدماغ.
ورثت الإمبراطورية الرومانية المنطقة، وكانت ترى أنّ الأمراض من عمل الآلهة، ولا شأن للطب بذلك، لكن مع الوقت تبنّت الثقافة اليونانية والهلينية، فظهر الطبيب جاليونس الذي وصف القلب بأنّه عضلة تأخذ فيها الألياف العضلية مسارات مختلفة على عكس عضلات الجسم الأخرى.
ومع انهيار الإمبراطورية الرومانية، دخلت أوروبا عصر الظلام. لم تسمح الكنيسة بتغيير المعتقدات، فقد أخذت برأي أرسطو بمركزية القلب ليتناسب إيمانيًا مع عقيدتها الدينية، فالقلب هو مركز الإيمان والحياة، إلى أن جاء القديس توما الأكويني واعتبر أنّ موضع النفس لم يكن في القلب، بل في هيئة الجسد البشري.
استلمت الحضارة العربية الإسلامية شعلة الحضارة، فقد تطوّر الطب كثيرًا في زمنها، وقد كان الرازي أول من تكلّم عن السكتات القلبية، إذ يقول إن في القلب طبائع فاسدة: “انسداد في شرايينه- وانسداد في تجويفه- وانتفاخ فيه، يليه تسارع في النبض ينتهي بالإغماء”، وهذا يعني بمصطلحات الطب في زمننا: “مرض تصلب الشرايين التاجي- داء تضيق الصمام القلبي- قصور القلب”.
أمّا ابن سينا الذي كان كتابه “القانون في الطب” مرجعاً لأطباء أوروبا لستة قرون، فقد وضع أيضًا رسالة في الأدوية القلبية، ووصف الحمية والرياضة لتقوية القلب، وأثبت أنّ منشأ الشرايين من الجهة اليسرى للقلب. كان الطبيب ابن النفيس يشرّح الحيوانات. وقد طرح فكرة وجود دورة دموية في الجسد البشري منطلقها القلب.
وبينما كانت أوروبا في ظلمتها، كان الهنود الحمر يضحّون بالقلوب لآلهتم، لكنّ أوروبا استفاقت أخيراً على يد مجموعة من العلماء الذين شكّكوا بالمعارف القديمة، فمن دافشني الذي رسم الكثير من الرسوم للقلب وتشريحه وإثباته أنّ الصمامات في الشرايين تسمح للدم بالعبور باتجاه واحد، إلى أندرياس فيزاليوس رائد التشريح في أوروبا في القرن السادس عشر، وصولًا إلى وليم هارفي في القرن السابع عشر، كانت الرؤية القديمة للقلب قد انهارت تمامًا، إذ أعلن الطبيب وليم هارفي أنّ القلب مجرد مضخة للدماء، لكن ظلّ القلب محورًا للإيمان والفنّ والأدب.
القلب والفنونتتالت اللوحات والأدبيات والمقطوعات الموسيقية التي تستخدم القلب كثيمة معبرة عن العاطفة والبراءة والحبّ النقي، إذ صوّر كيوبيد/ إله الحب يمطر العشاق بسهامه. وشاعت فيما بعد الكتب التي صممت على شكل قلب، والتي رأت فيه ممثلًا للذاكرة. وقد اختار مارتن لوثر مؤسس البروتستانتية شعارًا له زهرة على شكل قلب يتوسّطها الصليب.
ترافق استخدام ثيمة القلب في الرسم مع اعتباره موضوعًا مهمًا في الآداب، فبدءًا من دانتي وجيوفاني بوكاتشو صاحب “الديكاميرون/ مئة قصة”، بدأ ذكر القلب بقوة في القصص والروايات والأشعار؛ ففي الحكاية التاسعة من الديكاميرون يقتل الزوج عشيق زوجته، ويقطع قلبه ويطعمها إياه. وعندما يخبرها بذلك تقول له: “لقد تناولت أطيب شيء في حياتي، ولن أتذوق بعده طعامًا”، ثم ترمي بنفسها من النافذة وتموت.
ولم يفوت شكسبير رمزية القلب، ففي مسرحية الملك لير، لم تجد الصغيرة كورديليا طريقة للتعبير عن حبها لأبيها إلّا أن تقول له: “ما أضعفني من حمل قلبي إلى شفتي!”. لم يفهم الملك ما قصدته ابنته من قولها، فحرمها من الميراث. كذلك، عبرت الألحان الموسيقية عن ثيمة القلب، فقال أحد الموسيقيين: “للموسيقى فعل مفتاح سحري تنفتح به أشد القلوب انغلاقًا”.
اختصّ عيد العشاق في الرابع عشر من شباط بالقلوب، إذ غدا القديس فالنتاين رمزًا للعشاق، وأصبح خاتم الزواج يوضع في الأصبع الرابع/ البنصر للاعتقاد بأنّ هناك وريدًا ينطلق من القلب وينتهي إليه. وربما ربط القدماء هذا الإصبع في اليد اليسرى بالقلب لمراقبتهم الآلام التي تصيب المريض بالخناق الصدري، إذ تمتد من الصدر إلى اليد وتنتهي بالإصبع الصغير.
بعد هذا العرض لتاريخ القلب من منظور أسطوري وديني وأدبي وفنّي، ينتقل طبيب القلب فنسنت إم فيغيريدو إلى الحديث عن القلب من منظور طبي وعلمي، فيناقش وظائفه وكيفية القيام بها وأهم التطورات الطبية التي تخصّ القلب.
اعتبر القلب أهم عضو في الجسم على مدى جزء كبير من التاريخ المسجّل، إذ كان يُعتقد بأنّ في القلب، وليس الدماغ، الذكاء والذاكرة والعاطفة والنفس. ومع تقدّم الحضارة الإنسانية، تغيّرت وجهات النظر حول القلب. لقد رفض الطب والعلم الحديث ما كان ذات يوم ملك الأعضاء، فاعتبر القلب مجرد مضخة دم تابعة للدماغ. ومع ذلك ظلّ القلب رمزًا قويًا للحبّ والصّحة وجزءًا مهمًا من أيقونات الإنسان الثقافية.

https://www.almayadeen.net/arts-culture/%D8%A5%D9%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%D8%B1-%D8%A7%D9%D8%AC%D8%B3%D8%AF–%D8%B1%D8%AD%D9%D8%A9-%D9%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%D9%D8%A8-%D8%A7%D9%D8%A5%D9%D8%B3%D8%A7%D9 https://www.almayadeen.net/arts-culture/%D8%A5%D9%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%D8%B1-%D8%A7%D9%D8%AC%D8%B3%D8%AF–%D8%B1%D8%AD%D9%D8%A9-%D9%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%D9%D8%A8-%D8%A7%D9%D8%A5%D9%D8%B3%D8%A7%D9
April 29, 2024
خفايا الحرمين الشريفين… حكاية “الأغَوات” من الخصيان إلى الروايات الحديثة – رصيف22 – باسم سليمان
يروي الرحالة الألماني كرستين نيبور، الذي زار الحجاز عام 1762، لكنّه لم يصل إلى مكة، عن ثقات أخبروه بأنّ المهمة الأساسية لأغَوات الحرم النبوي في المدينة، هي حراسة الكنز العظيم الموجود في الحجرة النبوية، والذي يتكون من أحجار كريمة أهداها إلى المقام النبوي أثرياءُ المسلمين. وأهمّ هذه الأحجار ما يسمّى بـ”حجر الفلاسفة”، الذي يحوّل المعادن البخسة إلى معادن ثمينة من ذهب وفضة. وفي رواية أخرى لِنيبور، يقول إنّ الكنز هو عبارة عن كمية كبيرة من مسحوق يحوّل المعادن إلى ذهب.
ورد ذكر الأغوات في ثنايا الكتب التي أرّخت للأماكن المقدسة في الحجاز، ولدى الرحّالة الذين مرّوا بتلك الأماكن لاستكشافها أو قاصدين الحج. لكن من هم هؤلاء الأغوات حرّاس هذا الكنز العظيم؟
تتنوع أصول كلمة “آغا”، وجمعها في العربية أغوات؛ فنجدها في اللغة الكردية والفارسية والتركية، وهي ذات دلالات متقاربة، ففي التركية تعني السيد أو الرئيس. وعند الأكراد تطلَق كلقب على كبارهم وشيوخهم، ،في الفارسية تكتب بالقاف (آقا)، وتعني السيد، مقابل السيدة (خانُم).
وذكر ياقوت الحموي أنّ كلمة آغا تعني: الأخ الأكبر لدى المغول، وبعد الغزو المغولي دخلت اللغة الفارسية بمعنى سيد الأسرة. وفي عهد السلطان العثماني محمود الثاني، وبعد إلغاء الفرق الانكشارية في الجيش التركي أصبحت كلمة “آغا” تطلَق على الضابط غير المتعلّم/الأمّي. أما كلمة “أفندي” فغدت لقباً للضبّاط المتعلمين. وإلى جانب ذلك أُطلق اللقب على الخصيان الذين يعملون في القصور، حيث كان يرأسهم آغا أبيض أو أسود.
ربما يعود إطلاق لقب الآغا على خدّام الحرمين الشريفين في مكة والمدينة إلى الأتراك الذين كانوا يعيّنون مسؤولي الحرمين ويسمّونهم “الأغوات”. لكن اللقب السابق لهم كان “الطواشية”، أي الخصيان. وجاء في القاموس المنجد أنّ كلمة “طواشي” تعني: الخصي (طوش الرجل غريمه الذّكر، أي أخصاه)، حيث لحق لقب الطواشي بهؤلاء الخصيان من الزمن المملوكي.
ويذكر الرحالة السويسري بيركهارت، الذي قضى عشرة أشهر في الحجاز زار خلالها مكة والمدينة متخفياً مع حجاج نوبيين عام 1814، أنّ لقب طواشي/مخصي كانت تطلَق على خدّام الحرمين إلى جانب لقب آغا. ويؤكد محمد طاهر الكردي المكي، صاحب كتاب “التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم”، أن كلمتَي طواشي وآغا، تطلقان في الحجاز على الخصي، فيقولون “أغوات الحرم”، أو طواشيته، لأنّ المعنى واحد.
لم تكن الأماكن المقدسة في الحجاز من دون سدنة وخدّام يقومون عليها، فقبل الإسلام قسّم جدُّ الرسول قصي بن كلاب بين ابنيه عبد الدار وعبد مناف أعمالَ خدمة الكعبة، فكانت لعبد الدار الحجابة واللواء، ولعبد مناف السقاية والرفادة والقيادة. وبعد ذلك عَهدَ عبدُ مناف بالسقاية والرفادة إلى ابنه هاشم وبالقيادة إلى ابنه عبد شمس.
وأوكل عبد الدار الحجابة لابنه عثمان، وجعل دار الندوة لابنه عبد مناف. واستمر الحال على ذلك حتى جاء الرسول وألغى ذلك، لكنّه أقرّ سدانة الكعبة وسقاية الحجيج على ما كانتا عليه، كما ذكر الأزرقي في كتابه “تاريخ مكة”. وقد كان بعض الناس ينذرون أولادهم لخدمة الكعبة ومنهم الغوث، فقد نذرته أمُّه للكعبة إن حملت، فقد كانت عاقراً وجاء الغوث بعد نذرها، وتقول في ذلك شعراً:
إنّي جعلت ربَّ من بنيه/ربيطة بمكة العلية
فباركنّ لي بها إليه/واجعلْه لي من صالحِ الرّعِيّة
وعندما وُلي خالد بن عبد الله القسري إمارةَ مكة عام 98 هـ، وضع حرّاساً مع سياط لمنع النساء من مخالطة الرجال في الطواف حول الكعبة، وقد فعل ذلك بعد أن وصله قول الشاعر:
يا حبّذا الموسم من موفد/وحبّذا الكعبة من مشهدِ
وحبّذا اللاتي يزاحمننا/عند استلامِ الحجرِ الأسودِ
يذكر الأنصاري في كتابه “تحفة المحبّين والأحباب”، أنّ الخليفة معاوية كان أول من استخدم الخصيان لخدمة الكعبة، ويقال أيضاً ابنه يزيد، وفي رواية أخرى يقال إن الخليفة جعفر المنصور هو من أمر بذلك وعُمل باستخدام الخصيان لخدمة الكعبة بعد ذلك.
عن أغوات المسجد النبوي في المدينة، يقول ابن إياس في “بدائع الزهور” إن صلاح الدين الأيوبي هو من أقرّ هذا العرف، ولم يكن قبلاً معمولاً به. لكن هناك رواية أخرى تُنسب إلى السلطان نور الدين الزنكي الذي رأى حلماً كما جاء في كتاب “نزهة الناظرين” للبرزنجي، بأنّ الرسول جاء نورَ الدين في الحلم وطلب منه أن ينجده من شخصين أشقرين يحاولان أذيته. شدّ السلطان نور الدين الرِّحال إلى المدينة وأخبر أهلها بأنّه أعدّ صدقةً لهم، ليأتوه جميعاً.
وحدث أن أتى الجميع، فسأل هل بقي من أحد لم يأخذ الصدقة؟ فأجابه أهل المدينة بأن هناك رجلَين مغربيَّين صالحَين غنيّين لا يأخذان من أحد شيئاً، ويتصدّقان على المحتاجين. فطلب السلطان إحضارهما وعندما رآهما تيقّن من أنّهما الشخصان اللذان رآهما في الحلم.
وبعد استجوابهما ومعرفة مكان سكنهما وأنّه قرب الحجرة الشريفة، التي تضم قبرَ النبي، اكتشف السلطان أنّ هذين الأشقرين ما هما إلا صليبيين كانا قد نويا أن يسرقا جثمان النبي، عبر حفر نفقٍ إلى القبر، فقتلهما، وأمر بالحفر حول المقام حتى الوصول إلى الماء وصبّ الرصاص المصهور ليكون حاجزاً يمنع اللصوص. ومن ثم أرسل اثني عشر مخصياً من خدّامه الشخصيّين إلى الحرم النبوي ليكونوا سدنةً للقبر وحرماً له. يبدو أن هذه القصة تدخل في إطار التعبئة النفسية للمسلمين من أجل قتال الصليبيين.
لم يكن تعيين صلاح الدين أو الزنكي خصياناً للحرم النبوي مقبولاً، فقد اعترض عليه فقهاء المدينة، لكنّ أمرَ السلطة نافذ. ومن الفقهاء الذين ألّفوا رسالةً بحرمة ذلك كان السيوطي في كتابه “حرمة خدمة الخصيان لضريح ولد عدنان”. وأغلب الظن أن الفقهاء الذين اعترضوا على ذلك كانوا من الحنابلة والشافعية. أما الحنفية والمالكية فقد أقرّوا ذلك، لأن كلّ الخصيان الذين أوقِفوا لخدمة الحرم النبوي كانوا تابعين لمذهب من أوقفوهم، كما ذكر الرحالة أبو سالم العياشي في كتابه “ماء الموائد”.
ويذكر العسقلاني بأنّ الخصاء ممنوع في الإسلام استناداً إلى الحديث النبوي: “ليس منّا من خصي واختصى”، ويشرح العسقلاني السبب: “لأن الاختصاء، فيه تشويه وتغيير لخلق الله، وكفر بنعمته، واختيار للنقص على الكمال، وتشبّه بالنساء، وتعذيب للنفس وقد يفضي إلى الهلاك”. ويتابع العياشي ذكر الآراء المختلفة معللاً رغبة السلاطين في ذلك: “لكونه -أي الخصي- أطهر، وأنزه، وأكثر براءً، وأكثر فراغاً من الأشغال، إذ لا أهل ولا ولد يشتغل بهم، وهو أبعد من دنس الجنابة، ومباشرة النساء”. ومع ذلك كانت للأغوات الخصيان زوجات مثنى وثلاث ورباع كما ذكر بيركهارت وسراريّ حبشيات.
ويعلل العياشي ذلك بأنهم اتّخذوهنّ “للتلذذ بما سوى الجماع”. أمّا في الزمن الحديث وبعد إلغاء نظام الإماء، أصبح الأغوات يتزوجون ويقولون في عقد النكاح: “أملكت عليك مكحلة بدون مرود”، والقصد بأنه لا يملك العضو الذكري الجنسي والمرمّز إليه بالمرود. أما الزوجة فتملك العضو الأنثوي الجنسي المرمّز إليه بالمكحلة.
عندما أمر نور الدين أن يقوم الخصيان على خدمة الحرم المدني اشترط فيهم أن يكونوا حفّاظاً للقرآن ومعرفة العبادات، وأن يكونوا حبوشاً أي من الحبشة أو أرواماً من البيزنطيين أو من الهنود، ولربما يكون اختيار هذه الأجناس لكثرة المخصيين فيها، لكن كما هو واضح فقد استبعد العرب.
وعندما زار ابن جبير المدينة، ذكر أنّ خدّام الحرم المدني أحباش وصقالبة. بينما ذكر ابن بطوطة أنّهم أحباش. لكن مع الوقت تغيرت الأجناس، فأصبح أكثر المخصيين هنوداً. وعندما زار الرحالة هورغونيه مكةَ متخفياً في القرن التاسع عشر، ذكر أن أغلب أغوات الحرم المكي من “الخصيان السّود”.
يتم إحضار الأغوات الجدد عن طريق الأغوات القدامى في زمننا الحالي، فعندما يأخذ أحد الأغوات الأحباش إجازته ويقضيها في بلده إثيوبيا، يبحث عمّن تنطبق عليهم الشروط، ومن ثم يخبر شيخ الأغوات، فيتم استقدام الخصي الجديد ومنحه الجنسية السعودية لكن قبل ذلك يتم اختباره والأهم أن يكون مخصياً.
يتميز زيّ الأغوات عن غيره، فعندما أوقف صلاح الدين خصيانه لخدمة الأماكن المقدسة كساهم بأثواب بيضاء وعلّق عليها الشارات الخاصة بهم. وقد ذكر ابن جبير في رحلته إلى المدينة أنّ أغوات الحرم المدني “ظراف الهيئات، نظاف الملابس، والشارات”. والأمر نفسه ذكره ابن بطوطة. وقد أورد بيركهارت أوصافَ الأغوات في رحلته بأنهم يلبسون “عباءات إستانبوليةً” وأثواباً واسعةً مطرزةً مشدود عليها حزام ويحملون عصياً طويلةً بأيديهم.
أما اليوم فأثوابهم تختلف عمّا كانت عليه في الماضي، ففي السابق كان الآغا لا يستطيع أن يلبس الثوب وأزرار رقبته مفتوحة، إذ كان شيخ الأغوات يصفعه على وجهه أو يضرب رأسه بالحائط، قائلاً له: “زرّر حلقك”، ولم يكونوا يلبسون الساعة ولا يحملون الشماسي، إلا أن أغوات اليوم أكثر تساهلاً في اللباس. وكان للأغوات نظامهم الخاص الذي لا يتدخل فيه حكّام المدينتين المقدستين، ولهم رُتب كما في الجيش، فأكبرهم يُسمّى شيخ الأغوات. وتتدرج الرتب نزولاً ومن يموت منهم يحلّ مكانه من كان تحته بالرتبة.
لقد انتهى زمن الأغوات، فكما تذكر الباحثة السعودية سحر الدعدع، توقف استقدام الأغوات في أواخر السبعينيات من القرن الماضي بفتوى شرعية من مفتي السعودية، بعد أن علم بأنّ ذوي الأغوات يتعمدون خصي أبنائهم من أجل استقدامهم إلى مكة والمدينة لخدمة الحرمين الشريفين، وهذا يُعدّ بدعةً في الإسلام لا تجوز. لذلك تم إلغاء نظام الأغوات وتم استبدالهم بالمؤسسات الخدمية السعودية لتقوم على رعاية الحرمين المقدسين لدى المسلمين. لم يتبقَّ من الأغوات في عام 2024، إلا اثنين يتجاوزان الثمانين، وبموتهما سينتهي تاريخ “الخصيان” الذين خدموا الحرمين الشريفين.
سرد الكاتب السعودي إياد عبد الرحمن، في رواية “إهانة غير ضرورية”، والتي صدرت عن دار تكوين عام 2023، قصةَ آدم الذي نذرته أمه ليكون من الأغوات وقامت بإخصائه قائلةً: “كل ذلك لأجلك يا الله”.https://raseef22.net/article/1097169-%D8%AE%D9%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%D8%AD%D8%B1%D9%D9%8A%D9-%D8%A7%D9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%D9%8A%D9-%D8%AD%D9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%D8%A3%D8%BA%D9%D8%A7%D8%AA-%D9%D9-%D8%A7%D9%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9-%D8%A5%D9%D9-%D8%A7%D9%D8%B1%D9%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9
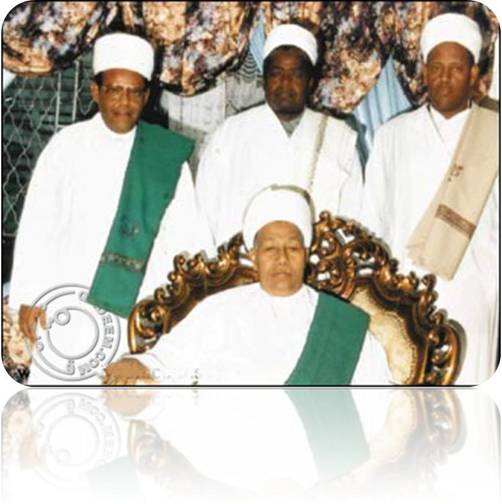
April 26, 2024
“كائنات مسكينة”: ما بعد فرانكشتاين – مقالي في ضفة ثالثة
باسم سليمان 26 أبريل 2024
هل تستطيع تخيّل ملامح وجهكَ وأنتَ في رحم أمّك؟ هذا السؤال لا يستهدف أيّة إجابة واقعية أو عقلية، فالغاية منه، أن يتم تعليم تلاميذ كهنة مذهب الزن الصيني، بأنّ الاستنارة لا تحدث وفق الأسئلة النمطية أو الإجابات المنطقية! وهذا ما يتغيّاه المخرج اليوناني يورغوس لانثيموس في فيلمه الجديد: “كائنات مسكينة/Poor Things” لعام 2023، الذي ارتكز على رواية الخيال العلمي للأسكتلندي ألسدير غراي بالعنوان ذاته، وقد قام بكتابة سيناريو الفيلم توني مكنمارا بالاشتراك مع الكاتب. وجسّد شخصيات الرواية في الفيلم كلّ من إيما ستون، ويليام دافو، ومارك روفالو. رُشح الفيلم لكثير من الجوائز، وفاز بكثير منها، مثل البافتا، واختيارات النقّاد، ومؤسسة شيكاغو، وغولدن غلوب. وأخيرًا توّجت إيما ستون بأوسكار 2024 عن دورها في الفيلم.
إنّ التغريب، أو السؤال الزنّي ــ من زن ــ الذي انتهجه لانثيموس في فيلمه بالعودة إلى العصر الفيكتوري بنزعته العلموية الصارمة وفلسفته المادية وأخلاقياته المتزمتة، قابله من جهة أخرى بسريلة ــ من السريالية ــ الواقع بمتخيل علمي فانتازي، فنرى عربة بخارية برأس حصان، وقطارات معلّقة، ومناطيد غريبة الشكل. وكل ذلك ترصده عدسة (عين السمكة) التي استخدمت في التصوير، مع أنّها تقدّم صورة محيطية كاملة، إلّا أنها تشوّه إطار الواقع وتضغطه؛ وهذا الأمر كان مقصودًا من لانثيموس ليصبح التغريب مرئيًا حتى في الأشياء العادية.
عبر هذا الأسلوب، قدّم لنا لانثيموس واقعَ ومتخيّلَ القرن التاسع عشر، الذي أنتج عالم الأحياء داروين من جهة، وهـ. جـ. ويلز، رائد الخيال العلمي، من جهة أخرى. وخاصة في روايته “جزيرة الدكتور مورو”، الذي كان يحاول فيها بطل الرواية الدكتور مورو عبر الجراحة تخليق كائنات تدمج بين البشر والحيوانات، ما دامت جميع الكائنات الحيّة قد تفرعت عبر تاريخ التطور الذي رصده داروين من خلية واحدة ــ إن صحّ التعبير مجازًا ــ فما المانع، ما دام الأصل واحدًا، أن يكون للأفرع قدرة على الاندماج. وهذا ما نراه في بيت الدكتور غودين (ويليام دافو)، فنرى خنزيرًا بجسد دجاجة. هذا التغريب للواقع كان القصد منه (إعادة ضبط) للمنظومة المعرفية والأخلاقية لدى المشاهد حتى يكون قادرًا على كسر التابوهات (المنطقية) العرفية القارة في ذهنه من أجل إعادة التفكير فيها، وتجاوز معقوليتها الضيقة إلى معقولية أوسع، وكأنّنا نغادر الكون البطليموسي إلى الكون الكوبرنيكي.
من هو د. غودين الذي نجده في فيلم لانثيموس؟ سريعًا، يتبادر إلى ذهننا مخلوق الدكتور فيكتور فرانكشتاين في رواية ماري شيلّي، الذي صُنع من أجزاء جثث مختلفة، وصُعق بالكهرباء فدبّت فيه الحياة. لقد تعرّض د. غودين في طفولته لعنف ممنهج من قبل والده باسم العلم والمعرفة والأخلاق، فأصبح مخلوقًا مشوّهًا على صعيد الوجه والجسد، ومخصيًا في الوقت نفسه، فوجهه أقرب إلى كولاج لملامح بشرية. تذكر شيلّي في روايتها بأنّ مخلوق د. فيكتور فرانكشتاين، والذي أصبح مشهورًا بلقب فرانكشتاين، حصل على القبول البشري لمرة واحدة، عندما التقى بأحد العميان، فلم ينكر تشوّهه وبشاعته ووحشيته. وعندما ذهب به إلى عائلته، أصيبت عائلة الأعمى بالهلع من رؤية الوحش، فما كان من فرانكشتاين إلّا أن قتلهم. ليس غريبًا أن يصبح دأب مخلوق د. فرانكشتاين قتل خالقه ما دام قد خلقه على هذه الشاكلة المخيفة، حيث تبدأ مطاردة مميتة بينهما تنتهي في القطب الشمالي على حدود العالم المأهول.
وهنا يتبدّى السؤال: لماذا هذا التناص بين سردية ألسدير غراي التي صدرت عام 1992، وكل من رواية شيلي وويلز؟ يعيش د. غودين في قصره الفيكتوري القوطي الهيئة، وهناك يجري تجاربه على الحيوانات والأجساد البشرية، ويقوم بتشريحها. وعلى الرغم من أنّه مشهور على الصعيد الطبي، إلّا أنّ هيئته الفرانكشتانية جعلته مرفوضًا من أناس مجتمعه. ولما حانت الفرصة ليصنع مخلوقًا يقبله/ يحبّه؛ كانت بيلا (إيما ستون) تلك الأنثى التي رمت نفسها من أحد جسور لندن كي تنهي حياتها؛ هي القدر المشتهى، التي وصلت إليه قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة. لقد كانت بيلا حاملًا فقام د. غودين باستبدال دماغ جنينها بدماغها، فنهضت من موتها تحت وقع صدمات الكهرباء بجسد ناضج ودماغ جنينها، إنّها فرانكشتاين أنثى! هكذا نرى بيلا الأنثى الناضجة جسدًا تتحرّى خطواتها الأولى غير المتّزنة وكلماتها الأولى بعقل طفل. لم تجفل بيلا من د. غودين، بل كانت تحبّه وتسمّيه: الإله! إنّ النقص الذي اعترى وجود فرانكشتاين شيلّي يتم تجاوزه في رواية غراي المقتبس عنها فيلم لانثيموس، فنحن أمام أنثى جميلة نزع منها ماضيها السيء، ومنحت حاضرًا ستصنعه بيدها.
كانت مملكة بيلا قصر أبيها، لا تخرج منه أبدًا، فهو يريد أن يحميها من قسوة العالم الخارجي الذي هربت منه بانتحارها، لكن بيلا لا تعرف شيئًا عن ماضيها أبدًا، فقد ولدت ليلة أمس بجسد ناضج وعقل طفلة. وعندما أدخل د. غودين أحد تلامذته إلى حياة بيلا، ليساعده بتدوين ملاحظات عن تطورها اليومي عبر تعداد خطواتها المتّزنة وعدد الكلمات الجديدة التي تكسبها كلّ يوم، يجد التلميذ أنثى مفعمة بالجمال، لكنّها كطفل تريد تجريب الأشياء عبر كسرها وطعن الجثث في مختبر أبيها والتلفظ بالكلمات النابية والتصرف بلا حياء، إلّا أنّها بريئة ونقية كصفحة بيضاء. يكتشف المساعد ماكس (رامي يوسف) حقيقة بيلا، لكنّه يغرم بها وتستلطفه بيلا، فيخطط د. غودين لزواجهما، فيحضر المحامي دانكن (مارك روفالو) ليكتب عقدًا يلزم كلًا من بيلا وماكس بعدم مغادرة القصر. تستثير شروط عقد الزواج دانكن، فيتسلّل لرؤية تلك البيلا التي يرى فيها تجربة أشبه باكتشاف قارة جديدة عذراء. تجد بيلا بالمحامي فرصتها لترى العالم والخروج من الشرنقة التي حبسها فيها والدها. لا يمانع الوالد إلّا ظاهرًا، وكأنّه كان يخطط سرًّا لحدوث ذلك. وعندما يناقشه ماكس بذلك يخبره بأنّ بيلا حرّة.
لقد كان التصوير بالجزء المتعلّق بحياة بيلا في القصر بالأبيض والأسود، وهذا ليس دليلًا على الزمن الماضي فقط، وإنّما على الحدّية التي يحياها د. غودين، فهو ابن الزمن الفيكتوري في إنكلترا، بكلّ تزمّته الأخلاقي، وعلمويته الباردة. وما إن تخرج بيلا من هذا الزمن، وتدخل حاضرها الشخصي، حتى تبدأ الألوان بالظهور من أصفر فان غوخ إلى أزرقه. لقد كانت بيلا تريد تذوّق الحياة بحواسها، وكأنّها مع المرحلة التي تكلم عنها سورين كيركغارد؛ وأطلق عليها اسم (المرحلة الجمالية)، حيث تنطلق بيلا لتجربة حواسها كلّها؛ بدءًا من الجنس بأبعاده كافة مع دانكن إلى الطعام والرقص، لكن من دون رقابة ذاتية ولم تكن لتعنيها رقابة المجتمع أبدًا. هذه الحرية صدمت المحامي المخادع، الذي رأى في بيلا أرضًا جديدة يروضها كما يريد، لكن بيلا كانت أكثر ثورية من غواية الشيطان ذاته، فتركته مفلسًا، بعدما تبرّعت بأموال كسبها من القمار لأولاد فقراء. ومن ثم خانته لتعلن له بأنّ جسدها ملكها لا ملكه، مع مقارنة تهكمية بمحدودية القدرة الجنسية لدى الرجل مقابلة مع الأنثى؛ وكأنّ بيلا تقول له بأنّ قمع الذكر للأنثى يأتي من هذا المنحى!
تتعرّف بيلا على القراءة، وتكتشف بأنّ الحياة أعمق من متع عابرة، فتقرأ الفيلسوف والشاعر رالف والدو إمرسون، وغيره. وتعرف أنّ الاستقلال لا يكون بالكلمة فقط، بل بالمال أيضًا. ولأنّها لا تملك مهارات بعد، تلجأ إلى أقدم مهنة في التاريخ/ الدعارة. وهناك ترى أنماط الرجال في المجتمع، من الغني الغندور إلى السادي، إلى الجاهل، إلى العجوز المتصابي، فتبتسم لمقدار الحماقة التي يعيشها البشر.
بعدما اكتسبت بيلا معارف كثيرة، تدخل المرحلة التأملية، وفق تقسيم سورين كيركغارد لحياة الإنسان، فهي، وإن كانت مولعة بمتع حواسها، إلّا أنّ في الحياة أشياء أخرى أكثر غنى وجدوى من متع الجنس والطعام. لذلك تعود إلى قصر والدها لأنّها تحبه حقًا على الرغم من فرانكشتانيته، وترضى بالزواج بمساعده ماكس. وفي لحظة عقد القران، يدخل زوجها القديم، ويطالب بها. إنّ بيلا ليست زوجته حقًا، فلقد ماتت منتحرة، وهي الآن بعقل جديد، وليس عقلها القديم، ومع ذلك تذهب معه، تريد أن تعرف ماذا حدث لأمّها/ لها! لم يكن زوجها إلّا ضابطًا مصابًا ببارانويا الارتياب، ظانًّا بأنّ الجميع يريد اغتياله، من خدمه إلى زوجته. الآن فهمت بيلا لماذا انتحرت، وتقرر أن تترك بيت زوجها لتعود إلى والدها المريض. يرفض الزوج، ويهدّدها، فتقدم على تخديره وحمله معها إلى قصر أبيها ليتم تحويله إلى كلب وفي بجسد رجل.
يموت د. غودين محاطًا بأحبته، وترثه بيلا فرانكشتاين القرن العشرين بعلميته وأخلاقياته النسبية، فلا حدود أخلاقية متزمتة ولا علموية، لا ترى بالإنسان إلّا مجرد آلة عضوية.
إنّه أمل جديد يسطع مع بيلا، حيث نراها تجلس في حديقة القصر تطالع كتابًا، وتستعد لأن تصبح طبيبة، بينما ترمق من حولها، زوجها اللطيف ماكس، وكلبها/ زوجها القديم، وفتاة مراهقة نسخة مصغرة عنها، كان أبوها ومساعده قد صنعاها في غيابها. يبدو المنظر العام مريحًا وبيلا بأخلاقيتها المنفتحة وعلميتها المتجدّدة قادرة على اجتراح عصر جديد، يتجاوز فيه الإنسان ذكورته السامة لينفتح على أنوثته اللطيفة.
ليس فيلم لانثيموس ديستوبيًا. وليس حتى نسويًا بالمعنى الحدّي، بل ما بعد ديستوبي، وما بعد نسوي، إنّه أشبه بأسئلة رهبان الزن؛ فهو وإن أسقط العصر الفيكتوري على لحظتنا الراهنة، إلّا أنّه بالمحبة التي تمت بين فرانكشتاين/ غودين/ الإله والأنثى/ بيلا؛ حرّر الأنثى/ الإنسان من ثيمة الغواية، وبأنّها المسبّب في الخطيئة الأساسية؛ هكذا تُفهم مظاهر العري التي قدّمتها بيلا، فعلى الرغم من فجاجتها إلّا أنّها ليست بمظهر الغواية، إنّما بهيئة الطبيعة الإنسانية، فبيلا ترفض الإسقاطات النمطية على جسدها من قبل الذكر والمجتمع. وتفكّك في الوقت نفسه المنظومة الدينية التي تجعلها مجرد ظل للشيطان، أمّا لناحية مخاطر العلم، فلولاه لم تكن قادرة على العودة إلى الحياة بدماغ ابنتها والانتقام من زوجها السادي. وما يقصده لانثيموس بأنّ العلم والإله والأخلاق، هي أشياء حيادية بذاتها وجيدة في الوقت نفسه. ونحن البشر في النهاية من نملك اليد العليا في جعل أمر ما خيرًا أو شرًا.
*كاتب من سورية.

April 17, 2024
“خاتم سُلَيْمى”: في ثنائية الحرب والحبّ
باسم سليمان16 أبريل 2024
ضفة ثالثة
لا مهرب للكاتب السوري من ثيمة الحرب، فبعد أكثر من ثلاث عشرة سنة ابتدأت في 2011 أصبحت الحرب وتداعياتها موضوعة حاكمة في النتاج الأدبي السوري لا يكون من دونها، فتحضر بأسماء عديدة حسب التجاذبات السياسية، فمن الحراك إلى الثورة إلى الإرهاب إلى الاسم الأشمل: الحرب؛ والتي تتبدّى تأثيراتها في المشهد الأدبي، تارة كصوت فاعل فيه، وتارة أخرى كصدى. وتظهر عادة مقابل ثيمة الحرب ثيمة الحبّ كترياق لسمّ الحرب يحاول كبح جماحها، وهذا ما تتغياه الروائية السورية ريما بالي في روايتها “خاتم سُليمى” (الصادرة عن دار تنمية لعام 2022 والتي وصلت إلى القائمة القصيرة للبوكر لعام 2024) إلّا أنّها تقدم مقاربة تفكيكية للطرف الثاني في هذه الثنائية ألا هو الحبّ، الذي يكون عادة في تضاد مع الحرب كعادة هذه الثنائية، لكنّ للحبّ معاركه وللحرب قدرتها على كشف زيف هذا الترياق كما مثّل لذلك بعضوي فرقة المتصوِّف سيلفيو شمس الدين كارليوني الإيطالي، مهند وصلاح؛ فهما صديقان وقريبان وموسيقيان منتميان إلى جو صوفي عشقي بوصلته جلال الدين الرومي، إلّا أنّ تلك الصفات المشتركة بينهما والتي من الممكن جمعها تحت بوتقة الحبّ لم تستطع أن تدفعهما إلى التسامي والغفران، فكلّ منهما تحزّب لطائفته وموقفه السياسي، فتحولا إلى قاتلين وقتيلين، مع أنّ القتل في التعريف اللغوي والصوفي، كما فسّره الحلاج، هو معرفة كنه الشيء أي جوهره، فهل كانا حقًا جديرين بالشطحات العشقية عندما كانا يعزفانها مع شمس الدين متغنّيين بصوفيات ابن الفارض والرومي وغيرهما ممن اجتذبهم العشق الإلهي والموت فناء فيه؟
مدينتان
تُعتبر حلب من أقدم المدن التي سكنها الإنسان في التاريخ، فلقد استوعبت دياناته المختلفة المشارب وثقافاته المتعدّدة واقتصادياته المختلفة، فكانت رمزًا للحضارة البشرية في السلم والحرب. وتعدّ توليدو/ طليطلة مدينة لها عمقها التاريخي كذلك، لكن ميزتها بأنّها مثّلت في الزمن الأندلسي حالة خاصة واستثنائية في الألفة بين المتناقضات، أقرب للصوفية حيث اجتمع أتباع الديانات السماوية الثلاث في حبّ ووئام، فأصبحت كقول ابن عربي: “فقد صار قلبي قابلًا كل صورة/ فمرعى لغزلان ودير لرهبان/ وبيت لأوثان وكعبة طائف/ وألواح توراة ومصحف قرآن”… من هذا الجذر تنسج بالي مقاربتها، فما الذي كان ينقص حلب أن تصبح استثناء كطليطلة وحتى لو في غمضة عين من تاريخ الإنسان المملوء بالحروب؟ ألهذا اختارت شخصية شمس الدين، هذا المستعرب الإيطالي الذي ربّته خادمة ليبية جاءت مع عائلته إلى إيطاليا بعد انتهاء الاحتلال الإيطالي لليبيا، فكانت أمًّا بديلة له بعد هرب أمّه البيولوجية مع عشيق لها بعد سنتين من ولادته حتى يكون جسرًا بين المتناقضات فيؤالف بينها؟ لقد فتحت تلك الخادمة العجوز عينه على ويلات الاحتلال والثقافة الليبية الغنائية الشعبية بنظرة مختلفة عمّا عهده في بلده إيطاليا، فنشأ محبًا للموسيقى شغوفًا بقدرتها لتكون لسانًا عالميًا قادرًا على فتح النوافذ في الجدران المصمتة، فاختار حلب لحدس ما يشبه انتقاله من ولعه بالغيتار الإسباني إلى آلة القانون العربي، لربما يجد فيه الوصايا العشر لحبّ لا يحوّله الإنسان بجهله إلى كره.
لم تكن ليلى ابنة الطبيب المسلم سامح العطار وجانيت المسيحية والتي غيّرت اسمها إلى سلمى كطليطلة، فهي لم تستطع أن تغفر لعائلة أمها مقاطعتهم ابنتهم لزواجها من خارج دينها، فبادلتهم الجفاء وقطع أواصر القرابة؛ وجاء تغيير اسمها إلى سَلمى والتي تعني: الناجية؛ لربما كمحاولة لا شعورية، سستتضح أكثر بعد أن تأكل الحرب حلب، حيث تذهب إلى دار رعاية المسنين لترى جدتها لأمّها التي بدأ ألزهايمر يمحو ذاكرتها. وجاء تعلّقها بشمس الدين تأكيدًا لهذا التغيير، فقد كان يقدم لها عبر صوفياته عالمًا يتجاوز تلك التناقضات السطحية بين الأديان، فازدهر حبّ من طرفها لكنّه غيّر حياتها، فعادت إلى مهنة جدها لأبيها لتفتح حانوتًا للعطارة وبيع التحف الشرقية والسجاد، وفتح قلبها لارتياد آفاق المحبة.
كان لوكاس والذي يعني اسمه ضوء الشمس أو المضيء ابنًا لعائلة مسيحية يهودية من جهة الأم والتي ما زالت تحمل مفتاح بيتهم في توليدو متناقلًا عبر الأجيال حتى وصل إليها، فأورثته إياه بعدما رفض أخوه الأكبر هذه الأمانة. يغادر لوكاس مدينته في شمال إسبانيا إلى توليدو هربًا من ظل أخيه الأكبر متتبعًا شغفه بالتصوير، ليصبح مصورًا مشهورًا في أوروبا حيث يتم اختياره من قبل جيهان صديقة سلمى التي تنتج الصابون الحلبي لينجز لها دعاية مصورة تكون ممرًا لها إلى العالمية. يسافر لوكاس إلى حلب وهناك يقع في غرام سَلمى، مع أنّه على علاقة بعارضة الأزياء (لولا) وقد أنجب منها ابنًا.
“تظهر عادة مقابل ثيمة الحرب ثيمة الحبّ كترياق لسمّ الحرب يحاول كبح جماحها، هذا ما تتغياه الروائية السورية ريما بالي في روايتها “خاتم سُليمى” (التي وصلت إلى القائمة القصيرة للبوكر لعام 2024) إلّا أنّها تقدم مقاربة تفكيكية للطرف الثاني في هذه الثنائية ألا هو الحبّ”
تتلاقى خطوط أقدار شخصيات الرواية وتتلاقح في أزمنة متعدّدة؛ فمن قبل الحرب إلى رابعة ليل الحرب إلى ما بعد الحرب، فهل ينجب هذا التلاقح الحبّ ما بين سَلمى وشمس الدين أو ما بين سَلمى ولوكاس؟ لم يكن شمس الدين يلاعب سَلمى الشطرنج عندما أدخلها في مراهنة ليتأكد من حبّها له مانحًا إياها كتاب “مثنوي” لجلال الدين الرومي كبوصلة تهتدي بها. لقد كان شمس الدين أسير طفولة معذّبة إثر هرب أمّه مع عشيقها الرسّام إلى جانب الفرق العمري الكبير بينه وبين سلمى، لذلك كان خائفًا في قرارة نفسه أن يكون حب سَلمى له مجرد فورة عشق وتنتهي! أمّا سَلمى فبالرغم من انخراطها في علاقة محمومة مع لوكاس إلّا أنّها لم تكن قادرة على اتخاذ قرار على أي جانب تميل بين شمس الدين ولوكاس، فكلّ منهما كان ضوءًا يمنحها ظلالها في حين كان لوكاس يرى ضوء شمس الدين يخالط ضوءه، فنوره الذي أضاء جسد سلمى لم يكن قادرًا على إزاحة نور شمس الدين عن روحها.
هل تشبه سَلمى حلب أم طليطلة؟ فما بين مسيحي غدا صوفيًا، ومسلمة رحم أمّها مسيحي، ومسيحي رحم أمّه يهودية، وما بين حبّ روحي وحبّ جسدي كان من المفترض أن تصبح سَلمى/ حلب طليطلة أخرى، لكنّ الحرب كانت لها الكلمة الفصل.
خاتم/ خاتمان
تصمّم سَلمى خاتمين لهما شكل تنين يلتف حول حجر كريم، تهدي أحدهما لشمس الدين في حين تزيّن إصبعها بالخاتم الثاني، ولقد استوحت تصميمهما ومعناهما من قصة خاتم الملك سليمان، الذي كان له القدرة بموجب خاتمه على السيطرة على الجان والبشر والطبيعة، فقد كانت تطمح إلى أن تكون لهذين الخاتمين قدرة على جمع مصيرها إلى قدر شمس الدين. يزور لوكاس حلب مرتين، الأولى للعمل والثانية ليكون أقرب إلى سلمى، ويجذبه خاتم سلمى، لكنّها ترفض إهداءه له وكأنّها ضمنًا ترفض لوكاس، أمْ أنّها تريد منه فعلًا أن يستحق من خلاله هذا الخاتم؟ تدور رحى الأيام والحرب والحبّ والمرض، فتخسر سلمى مشغلها وتحفها لكنّها تبقى في حلب ويزداد تعلّقها بشمس الدين، بينما يُدمر بيت شمس في حي باب قنسرين وتتفرّق فرقته السورية وتحرق الحرب ذكريات الحبّ والسلام الذي عاشه في حلب، وينتهي إلى أن ينهشه مرض السرطان، لكنّه يتصالح أخيرًا مع كل ماضيه. أمّا لوكاس فيزداد انغماسه بحبّ سَلمى التي تهديه سجادة لها حكايتها الخاصة وشموع ذات رائحة عطرة طالبة منه أن ينام على السجادة التي تشبه بساط الريح لربما تقوده أحلامه لفهم أكبر لحبّه لها.
كان لوكاس قد اختتم زيارة عمل إلى لبنان، وفي طريق عودته وأثناء وجوده في المطار يدخل إلى دورة مياه للرجال وهناك يجد خاتمًا يشبه خاتم سَلمى، ليتضح له فيما بعد أنّ شمس الدين قد رتّب خطّة ليصل إلى يده. كان شمس الدين يعيش أيامه الأخيرة بعد عودته من حلب المدمّرة إلى إيطاليا في ذات الوقت الذي كان لوكاس فيه في مطار بيروت. لم يحدث اللقاء بين شمس الدين ولوكاس على الصعيد المكاني، إلّا أنّهما التقيا روحيًا، حيث وجد شمس الدين في لوكاس شمسًا أخرى ستشرق قريبًا في سماء سَلمى.
بينما كانت سلمى تحضر حرق جثة شمس الدين كما رغب، يأتيها خبر مفجع من ابن لوكاس بأن والده قد تعرّض لحادث أدخله في غيبوبة ومن ثمّ تطير إلى إسبانيا لترى لوكاس في غرفة العناية المشدّدة، وهناك تترك خاتمها وديعة لدى ابن لوكاس. يستيقظ لوكاس من غيبوبته، ليجد أنّه قد تحصّل على الخاتمين، فيجري بحثًا على الإنترنت ليجد أنّ شمس الدين لم يمت، وأنّه هو من مات في حادث السيارةّ! هذه المفارقة في نهاية الرواية تضاء بالاقتباس الذي وضعته ريما بالي في مقدّمة الرواية عن جبران خليل جبران: “إنّ حياة الإنسان يا سَلمى لا تبتدئ في الرحم، كما أنّها لا تنتهي أمام القبر، وهذا الفضاء الواسع المملوء بأشعة القمر والكواكب لا يخلو من الأرواح المتعانقة بالمحبة والنفوس المتضامنة بالتفاهم”؛ فهل نحن أصوات وأصداء لأناس ماتوا علينا أن نروي قصصهم وننعش ذكرياتهم حتى لا تصبح الحرب ممحاة كبرى لا تبقي ولا تذر؟ لقد ملأت ريما بالي روايتها بتفاصيل حلب قبل الحرب، فمن المباني التراثية إلى الأسواق الشعبية إلى الأكلات الحلبية إلى الغناء والموسيقى. وفي الوقت نفسه ضجّت روايتها بالأسئلة عن الحرب والثورة والحب والكره والغفران والتسامح؛ فتركت استخلاص الأجوبة للقارئ، في هداية هذين السؤالين: هل للحرب قدرة على أن تشطب مدينة من الوجود؟ وهل للحبّ استطاعة أن يبعث فيها الحياة من جديد!
سُليْمى
هو تصغير لاسم سَلمى، لأنّها لم تكن ناجية كبيرة كاسمها عندما استبدلت بليلى سَلمى، لكنّها نجت، لذلك ناداها شمس الدين بالاسم المصغّر من اسمها: سُليْمى؛ أي التي ما زالت على قيد الأمل/ النجاة. لقد فازت بحبّ شمس الدين وهو على فراش الموت، عندما أدرك أنّ تلك الشابة التي أنضجتها الحرب كانت صادقة ولن تفرّ منه، لا كما فعلت أمّه مضحية بأمومتها لصالح عشق مجنون. وفي الوقت نفسه أدرك لوكاس كم كان ينقصه من الشجاعة والجرأة ليوطّن نفسه في قلب سُليْمى، مع أنّها سلّمت له جسدها. أمّا سُليمى، فقد أصبحت حيّ (طليطلة) في حلب، فكم تحتاج الحروب إلى سُليْمات حتى تنتهي إلى السلام.
إجمالًا، تعتبر رواية ريما بالي “خاتم سُليْمى” إضافة جديدة إلى رواية الحرب السورية، وخاصة أنّها عالجت جانبًا خاصًا من ثيمة الحبّ؛ المقابل الوجودي للحرب، وأظهرت كم أنّ هذه العاطفة تحتاج إلى غفران وتسامح مثلها مثل الحرب، بل إنّها قد تكون مستصغر شرر له حرائقه أيضًا، والتي قد تؤدي إلى حروب كبيرة؛ أليس كلّ أطراف الحرب السورية، بين أحياء وأموات يدّعون حبًا لليلى/ سلمى/ سُليْمى/ سورية.
*كاتب سوري.

https://diffah.alaraby.co.uk/diffah/books/2024/4/16/%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9-%D8%B3%D9%D9%8A%D9%D9-%D9%D9%8A-%D8%AB%D9%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%D8%A7%D9%D8%AD%D8%A8 https://diffah.alaraby.co.uk/diffah/books/2024/4/16/%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9-%D8%B3%D9%D9%8A%D9%D9-%D9%D9%8A-%D8%AB%D9%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%D8%A7%D9%D8%AD%D8%A8
April 6, 2024
“عرقٌ متوهّم”: عن تهافت أعذار الصهيونية
باسم سليمان 6 أبريل 2024 – ضفة ثالثة
يأتي الكتاب الجديد للباحث الإسرائيلي شلومو زند (ساند) “عرق متوهّم: تاريخ موجز لكراهية اليهود” الصادر عام 2020 (والذي صدر بالعربية عن دار مدارات للأبحاث والنشر عام 2024 من قبل المترجمين يحيى عبد الله، وأميرة عمارة) كمرافعة تاريخية من قبله لربما تبريرًا لبقائه في إسرائيل، إذ يقول: “كلّ كاتب للتاريخ مقيّد بروح العصر، وبطبيعة المكان، اللذين يحيا فيهما، وإذا كان منصفًا، فإنّه يتوجّب عليه أن يبذل جهدًا، وأن يكشف بقدر المستطاع الشحنات الذاتية التي تُرجّح موقفه من التاريخ وتصوغه”. لقد أراد شلومو من هذا الكتاب أن يقدم تاريخًا موجزًا للعوامل التاريخية التي دفعت اليهود إلى إقامة دولتهم على أرض فلسطين! وفي الوقت نفسه، كشف عن الأصول الدينية والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية لكراهية اليهود في المجتمع الغربي المسيحي.
ينطلق شلومو من اللحظة التي بدأت فيها كراهية اليهود تأخذ شكلًا عملاتيًا، فالعيش في وسط اجتماعي يعتقد بأنّ اليهود قد قتلوا ابن إله هذا المجتمع ـ المسيحي ـ سيُنتج هويات منغلقة. وما يقصده شلومو بأنّ انطواء المجتمع اليهودي على ذاته لم يكن ناتجًا من العقيدة اليهودية، بل إنّ العقيدة المسيحية هي من فرضت ذلك على الأقلية اليهودية التي تعيش بين ظهرانيها، مستشهدًا بقول الفيلسوف سارتر بأنّ النظرة المجتمعية لليهودي ناتجة عن نظرة الآخر له. وإذ يستكمل مقولة سارتر، فيقول، بأنّ العقيدة الدينية اليهودية هي نتاج المؤسسة الدينية النصرانية المعادية لليهود. ويشرح هذه النتيجة عبر إيراد زمن التسامح الديني في الأندلس بين المسلمين واليهود والمسيحيين، حيث انفتح اليهودي على الآخر.
لم تصبح اليهودية ديانة منغلقة على ذاتها، إلّا بعد انتصار المسيحية مع الإمبراطور الروماني قسطنطين في القرن الرابع ميلادي. قبل ذلك، كان التهوّد ـ أي دخول الديانة اليهودية- متاحًا لمن هم خارج نسل الأسباط الاثني عشر ـ ففي سفر (إستِر) الذي دوّن في مطلع القرن الثاني قبل الميلاد، نجد: “وكثيرون من شعوب الأرض تهوّدوا، لأنّ رعب اليهود وقع عليهم”، فلم يكن مصطلح (تهوّد) مذكورًا قبل ذلك في الأسفار التوراتية، ثم ورد أيضًا في سفر (روت) بأنّ النبي داود يعود في أصله العائلي إلى فتاة متهوّدة؛ وهذا يعني في رأي شلومو بأنّ الانعزال التوحيدي للعقيدة اليهودية لم يكن بداية متشدّدًا، فلقد أجبرت مملكة الحشمونائيين اليهودية شعب الأدوميين في فلسطين أن يصبحوا يهودًا. يتابع شلومو زند بذكر الأخبار التي تؤكّد انفتاح العقيدة اليهودية على الآخر بعيدًا عن فكرة نقاء الدم للعرق اليهودي، فالفيلسوف فيلون الإسكندري كتب بأنّ الجميع سيعتنقون المبادئ التوراتية. أمّا المؤرّخ فلافيوس يوسيفيوس، فيشير إلى انتشار عقيدة اليوم السابع بين سكان المعمورة. أمام هذا الواقع تصبح مقولة المؤرِّخ الروماني ديو كاسيوس في القرن الثالث ميلادي مفهومة، فهو لا يعرف السبب بتسميتهم اليهود، لأنّهم ينتمون إلى أعراق شتى. وعلى المنوال نفسه في التفسير، يقدّم المفسِّر الأصيل للتوراة أوريجينس، بأنّ اليهودي ليس اسم عرق، بل اختيار عقائدي، فإذا قبل إنسان ليس من أمة اليهود منهاجهم، فإنّه يصبح يهوديًا. هذه النظرة المنفتحة تجاه الآخر المتهوّد أكّدها الحاخام شمعون بن لاكيش، الذي يرى بأنّ المتهوّد أحبّ إلى الله من اليهودي الذي كان على جبل سيناء، لأنّه آمن من دون أن يرى.
لم يكن الفرق بيّنًا بين اليهودية والمسيحية بداية، لذلك نجد الرسول بولس اليهودي الذي اعتنق المسيحية في ما بعد يصرّ على هذا الفرق. وهذا ما نجده في إنجيل يوحنا على لسان السيد المسيح مخاطبًا اليهود: “أنتم من أب هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا”. انتهت علاقة اليهود مع المسيح بأن سلّموه إلى الرومان، الذين صلبوه؛ قائلين للحاكم بيلاطس: “دمه علينا وعلى أولادنا”. بدأ الشقاق يتّسع بين اليهودية والمسيحية، التي بدأت في تنميط اليهود باعتبارهم العرق الذي لم يؤمن بالمسيح، وأن المسيحيين أصبحوا بذلك شعب الله المختار، فذهب القديس جاستن مارتر للقول: “ألسنا نحن، الذين قُددنا من حضن المسيح، العرق الحقيقي لبني إسرائيل”.
هكذا أصبح المسيحيون شعب الله المختار، وكان لا بد من أن يتم طرد اليهود من هذا النَسب الإلهي. ولولا العقيدة التي بناها الفيلسوف القديس أوغسطين، والبابا جريجوريوس، مؤسس البابوية في القرن السادس ميلادي، بأنّه من الضرورة إبقاء اليهود كشهود أذلاء، فوجودهم المهين هو الدليل الأزلي على صدق وتفوق المسيحية واتباعها الدين الحق، لتمَّت إبادة اليهود منذ زمن. كان القديس جاستن مارتر أول من تكلّم عن نفي اليهود عن فلسطين كعقاب من الله. لقد تبنّى اليهود النفي المسيحي لهم كعقيدة، فظهرت عقيدة الشتات في ثقافتهم، كرد فعل على الاضطهاد المسيحي، فهم قد ظلّوا أوفياء لعقيدتهم، على الرغم من كل ما حاق بهم من أخطار.
لقد حدّدت التشريعات المناهضة لليهود في الإمبراطورية المتنصرة وضع العقيدة اليهودية عبر العزل والاضطهاد، لكنّها لم تصل إلى حدّ إبادة اليهود. في منتصف القرن الخامس عشر، ومع انتشار الطباعة، وظهور النزعة الإنسانوية عند المفكّرين الغربيين، ظلّت النظرة المجحفة في حقّ اليهود قوية، فالمفكّر إيراسموس، صاحب كتاب: “مديح الحماقة” عبّر عن كرهه لليهود بالقول: “إذا كان يتوجّب علينا لكي نكون نصارى جيدين أن نمقت اليهود، فإنّنا كلّنا نصارى جيدون”. ولا يختلف الأمر عند مارتن لوثر، مؤسس البروتستانتية، فعلى الرغم من وقوفه ضد الكنيسة الكاثوليكية، وإصداره كتابًا بعنوان “عن كون يسوع يهوديًا بالولادة”، وتعاطفه مع اليهود، إلّا أنّه في النهاية أعلن موقفه الواضح منهم عبر كتاب بعنوان “عن اليهود وأكاذيبهم”. أمّا فولتير المعارض الشديد للكنيسة، فقد أعلن عن رفضه لليهود، فهم وفق رأيه: “لا يعرفون كرم الضيافة، ولا العطاء، أو الرحمة. سعادتهم البالغة في إقراض الأجانب بالربا الفاحش”. لا ريب في أن نظرة فولتير قد نشأت من العنصرية، ورفض الآخر، المبثوثة في ثنايا التوراة، بالإضافة إلى أنّ التلمود لم يكن يعيب على اليهود إقراض الآخرين ـ غير اليهود ـ بالربا الفاحش. يعلّل هذه النقطة الأخيرة شلومو بأنّهم ـ اليهود ـ لم تبق المنظومات الاقتصادية والاجتماعية لهم إلّا حرفًا بسيطة للعمل فيها، وإقراض الآخرين المال. بالإضافة إلى أنّ اليهود قد توسّطوا العلاقة الاقتصادية بين أصحاب رأس المال الكبار من اللومبارديين الإيطاليين والطبقات الفقيرة، فظهروا بمظهر التاجر الحقير الدنيء.
بدأت علائم التغيير تظهر في القرن الثامن عشر بعد الثورة الفرنسية، فقد رفض روبسبير، أحد مفكّري الثورة الفرنسية في الجمعية التأسيسية للدستور الفرنسي، الأفكار السائدة عن اليهود؛ فكيف للمضطهَد أن يكون مضطهِدًا. ومن ثمّ تم إقرار القانون الذي يعطي حقوقًا متساوية لليهود مع الفرنسيين. ومع ذلك، رفض بعض قادة اليهود تلك المساواة في الحقوق، خوفًا من تقويض العادات اليهودية. لكن أكثر اليهود كانوا متحمّسين للدخول في الزمن الحديث.
اتبعت الدول الأوروبية فرنسا في منح اليهود حقوقًا متساوية مع مواطنيها، لكنّ حادثتين أعادتا تأجيج مشاعر الخوف لدى اليهود، ففي عام 1840 اتهمت مجموعة من اليهود في دمشق بخطف راهب فرنسي وخادمه السوري من أجل قتله وإعداد فطيرة عيد الفصح بدمه. هذه القضية أشعلت الصحافة والمجتمع الفرنسي ضد اليهود. وفي حادثة أخرى عمدت إحدى الخادمات لتعميد طفل يهودي بولوني مريض خُشي عليه من الموت بعد مرضه، لكي لا يموت كافرًا. عاش الطفل، وعلمت شرطة الفاتيكان بذلك، فانتزعته من أهله كي يعيش مسيحيًا. أدّت هاتان الحادثتان إلى نشوء منظمات يهودية عالمية، لكن لم تسع هذه المنظمات للانتقاص من انتماء أعضائها اليهود إلى بلدانهم الأوروبية. لكن في الوقت نفسه ظهرت دعوات ترى في اليهود عرقًا ساميًا لا علاقة له بالأعراق الهندوأوروبية يجب إبعاده عن أوروبا، حيث كان المفكّر الاشتراكي الفرنسي شارل فورييه رائد هذه الدعوة، بل نستطيع أن نعده أول صهيوني، إذ كان يرى في اليهود شعبًا وقومية، وإن لم تكن متحضرة؛ ومن أجل ذلك يجب إعادتهم إلى موطنهم (فلسطينا)، وجعلهم يعملون في (بالانسترات: عبارة عن تجمعات زراعية تعاونية) من أجل تخليصهم من أخلاقهم الربوية السيئة. لم تكن فكرة الأعراق قد توطدت بعد، لكن إرهاصاتها بدأت بالظهور في القرن التاسع عشر. وقد ساهم كتاب داروين الذي تكلّم فيه عن البقاء للأقوى في عالم الحيوان إلى استخدام هذا الطرح العلمي، وإحالته إلى تصنيف البشر إلى أعراق ثلاثة: الأبيض وأكثر من يمثّله الآريون، ثم الأصفر، وتعبر عنه شعوب شرق آسيا، وأخيرًا الأسود في أفريقيا. هذه التراتبية العرقية رأت بأنّ اليهود عرق أبيض، إلّا أنّه سامي المنشأ، وبالتالي لا يستحق الرتبة التي نالها الآريون، حتى أنّ هناك صحافيًا يدعى فيلهام مار أصدر كتابًا بعنوان “انتصار اليهودية على الجرمانية”، وقد أصبح أكثر الكتب مبيعًا، تعبيرًا عن مدى الصراع العرقي بين اليهود والأوروبيين.
كانت فكرة الأعراق البشرية ونقاء الدم موجودة في الثقافة المجتمعية للشعوب منذ القدم، لكنّ الرأسمالية التي تقوم على فكرة المنافسة حفّزت قضية الأعراق في القرن التاسع عشر، ومع التطور العلمي بدأ الحديث بجدية عن أعراق مختلفة تتجاوز التصنيفات القديمة بين أبيض وأسود. وظهرت كثير من الكتب التي ترى في العرق السامي اليهودي خطرًا على أوروبا؛ هكذا اختلطت الكراهية الدينية لليهود بالإرث الاجتماعي الاقتصادي وعلم البيولوجيا، فأصبح اليهود قتلة الإله القدامى طفيليات الاقتصاد الحديث، الذين ينتمون إلى عرق دخيل زحف من آسيا، وتسلّل بدهاء إلى عروق الدم النبيل للعالم الأبيض المسيحي، ممّا مهد للنازية أن تجد الأسباب الدينية والاجتماعية والاقتصادية للقضاء على اليهود.
في هذه الأجواء المحتدمة، جاءت قضية الضابط الفرنسي اليهودي درايفوس المتهم بالتجسّس لصالح ألمانيا التي كانت قد احتلت مقاطعتي: الألزاس واللورين، لتزيد الوضع انقسامًا، ولتكشف الكراهية تجاه اليهود في المجتمع الفرنسي، والتي تصدى لها الأديب إميل زولا بمقال جاء بعنوان “إنّي أتهم”. في خضم هذه المعمعة، ظهر صحافي سيكون له دور كبير في نشأة الحركة الصهيونية، يدعى تيودور هرتسل، وهو صحافي نمساوي حاول جاهدًا أن يجابه كراهية اليهود في أوروبا بأن يصبح قوميًا ألمانيا، إلّا أنّ قضية درايفوس كشفت له زيف هذا التمنّي، ومقدار المعاداة لليهودية في أوروبا، لذلك عكف على تأليف كتاب “دولة اليهود”، وقد صيغت فكرة هذا الكتاب لأول مرة في نصٍّ سُمّي “خطاب لآل روتشيلد”. كان هرتسل يأمل بأن يتبنّى الثري روتشيلد فكرة القومية اليهودية، وهكذا انتهت قضية درايفوس إلى ميلاد الحركة الصهيونية. وقد خطرت فكرة وطن قومي لليهود لهرتسل وهو يسمع موسيقى فاغنر التي ألهمت أيضًا القومية الألمانية!
لقد عارضت الجموع اليهودية فكرة الصهيونية، وعندما شرع هرتسل بإقامة المؤتمر الأول لها في مدينة ميونيخ الألمانية عارضه الحاخامات، حيث وقع 78 منهم عريضة تمنع إقامة هذا المؤتمر من أصل 90. وحتى عندما ذهب هرتسل إلى بازل في سويسرا طالبت أكثر من 500 طائفة يهودية بمنع المؤتمر، ولم تلق فكرة هرتسل قبولًا كبيرًا إلّا بعد الحرب العالمية الثانية وما حدث من إبادة تجاه اليهود من قبل النازية.
لا يكتفي شلومو زند بسرد تاريخ كراهية اليهود من زاوية واحدة، بل يتعدّى ذلك إلى رؤية الصهيونية التي بدأت باستخدام قضية العرق اليهودي والدم اليهودي، وبأنّهم شعب الله المختار، لحشد اليهود المتواجدين في العالم لدعم إسرائيل. هكذا تبنّت الصهيونية الأدوات ذاتها التي قُمع بها اليهود في العالم. ويعرض المؤلف تلك المفارقة فيقول: “كلّما انحسرت الكراهية التقليدية لليهود، وأصبح تصنيف اليهود بحسب العرق نادرًا وهامشيًا في أنحاء العالم؛ ازداد النقد والعداء تجاه دولة إسرائيل وممثليها”.
لصدر كتاب شلومو زَند هذا قبل ثلاث سنوات من أحداث غزّة؛ والآن مع ما يحدث من إبادة ممنهجة للفلسطينيين، هل سيكتب شلومو كتابًا بعنوان: أنقذوا الفلسطينيين من الصهيونية؟ ليست الإجابة سهلة! لكن كتاب: “عرق متوهّم: تاريخ موجز لكراهية اليهود” مهمّ جدًا، فهو يفضح تهافت أعذار الصهيونية لتبرير إقامة دولتها على أرض فلسطين ما دامت تستخدمها هي ذاتها لقمع الشعب الفلسطيني، فوضع الفلسطينيين في غيتوهات، وإبادتهم، ومنعهم من تقرير مصيرهم، واعتبارهم مواطنين من الدرجة العاشرة في دولة إسرائيل الديمقراطية! كفيل بجعل إسرائيل دولة نازية. لربما علينا أن ننتظر إميل زولا جديدًا يكتب مقالًا في الغرب: (إنّي أتهم الصهيونية) حتى يستفيق الغرب لجنايته الجديدة بحقّ الشعب الفلسطيني، فكما قال شلومو زند عن تعامل الغرب مع قضية فلسطين بأنّه لم يكن يومًا إلّا “منافقًا ومارقًا”.

March 26, 2024
الضحك في الأساطير: عن وجودنا المؤقت على الأرض
باسم سليمان 26 مارس 2024 – ضفة ثالثة
قد نكون الكائنات الوحيدة التي تضحك في هذا الكون، فالحيوانات لا تفعل ذلك، وحتى القرود التي قد نجد شبهًا للضحك البشري لديها – على صعيد الصوت وحركات الوجه- فلم يثبت حتى الآن ضحكها على المثيرات التي تحفّز الضحك لدى الإنسان، كالنكتة والفكاهة أو التزحلق على الأرض بسبب قشرة موز! وحتى لو أخبرناها بأنّنا – البشر والقرود – نعود إلى جد أعلى مشترك، فلن نسمع قهقهاتها أبدًا، لربما تحزن! إنّ الحيوانات لا تدرك المكيدة بين حدي الوجود، فمن يُولد مقدر عليه الموت. ولربما لو أدركت هذه المعضلة لأصبحت إحدى فكاهات مذهب الزن الصيني أكثر الفكاهات تداولًا بين الحيوانات: “لو كان كل من جلس تحت شجرة، سينال الاستنارة كبوذا، لكانت الضفادع استنارت لجلوسها الدائم”. أمّا لو اتجهنا نحو السماء حيث مسكن الآلهة، فالآلهة متعالية جدًا لنتصور أنّها تضحك بسبب نكتة قائمة على التناقض، فالمفاجأة في خاتمة النكتة والتي تسبب المفارقة المولّدة للضحك لا يمكن أن تحدث مع سكّان السماء أصحاب المعرفة الكلية. بينما لو اتجهنا نحو الكائن البشري هذا الحدّ الأوسط بين الألوهة والحيوان، فبمقدار صلاحية تسميته بالحيوان العاقل كما فعل أرسطو، يصلح أن يطلق عليه الحيوان الضاحك، ولربما يعود ذلك لإدراكه لمدى هشاشة وجوده على هذه الأرض وهذا ما يذهب إليه تيري إيغلتون(1) في تحليله للإله ديونسيوس إله الخمر والمجون في الثقافة اليونانية، فعلى الرغم من مظاهر الفرح والسعادة التي تعمّ أتباع هذا الإله لكن كثيرًا ما تنتهي حفلاتهم الماجنة بالموت؛ إذن الموت نقطة آخر سطر الضحك؛ ألهذا نقول: “الله يجيرنا من شرّ هذا الضحك!”. يذهب ديزموند موريس(2) بأنّ الضحك قد تطوّر عن البكاء، فالطفل يأتي باكيًا إلى هذا العالم، لكنّه يتعلّم الضحك قبل اللغة والتفكير العقلي، فهل يفعل ذلك لإدراك فطري بأنّ حياته مجرد دعابة مؤقتة؟ هي أسئلة تراود الإنسان وهو يرى قتامة وجوده على سطح الأرض، لذلك يقابل هذه التعاسة بالضحك “أن تضحك، هو أن تعيش بعمق” إنّ هذه المقولة مقتبسة من كتاب ميلان كونديرا؛ (الضحك والنسيان). يعرض إيغلتون في كتابه نظريتين قد سادتا الفكاهة، الأولى نظرية التفوّق، أي أنّنا نضحك من عيوب الآخرين، كما قال أرسطو واتبعه فيها الكثير من الفلاسفة والمفكرين. والثانية نظرية الإطلاق ويقصد بها تخفيف التوترات النفسية؛ إذ أنّ بقاءنا جدّيون، هو دليل على نجاح القمع والرضوخ لتعاستنا.
تكاثرت المقولات عن الفكاهة والضحك، حيث تناولها الكثير من الفلاسفة، حتى شوبنهاور المتشائم رأى في البشر كائنات مضحكة تجري إلى العدم. في حين صنّف نيتشه المفكرين وفق حبّهم للضحك، مزدريًا العابسين. وقال المفكِّر الإنكليزي وليام هازليت، بأنّ للفكاهة أشكال عديدة وأوجه مختلفة وأن محاولة جمعها في تعريف جامع، هو عمل مضحك!
انتقد الفيلسوف اليوناني أكسانوفان، صفات آلهة الأوليمب، التي لا تتورّع عن الحسد والجشع والانتقام والضحك، وأطلق فكاهته التي لم تزل تتردّد إلى الآن: “لو استطاعت الخيول والثيران أن ترسم، لصوّرت آلهتها على هيئتها” كما ذكرت جينفر هيكت في كتابها: (تاريخ الشك). لقد رأى أكسانوفان بأنّ الآلهة يجب أن تكون متعالية عن طبائع الإنسان، فلا يجوز لها أن تغضب أو تضحك أو تسخر، فهذه مشاعر بشرية؛ وما أراده أكسانوفان من مقولته، بأنّ الآلهة يجب أن تكون متعالية عن الصفات البشرية المحدودة. وقد عاب أفلاطون على هوميروس تصويره في الإلياذة آلهة الأوليمب وهي تضحك وتسخر من عرج إله الحدادة هيفيستوس. إذن -ومهما يكن- كان لدى الإنسان تصوّر ما، على الأقل في أساطيره وخرافاته، بأنّ الآلهة تضحك، فهل لنا أن نسأل عن الضحك في السماء!
يُقال أنّ الفراعنة كانوا يعتقدون بأنّ العالم خُلق من الضحك(3) فعندما أراد الإله أن يخلق العالم أطلق ضحكة، فكانت أرجاء العالم السبعة، ثم أطلق ضحكة أخرى فكان النور، ثم ضحكة أخرى للماء،… أمّا الضحكة السابعة، فخلقت منها الروح! قد تكون هذه الأسطورة مجرد دعابة سوداء تقابل بها جديّة الكلمة الإلهية، مع أنّ الكثير من النكات والفكاهات تأخذ شكل الكلمات، لذلك يُقال للشخص الضاحك: لديه روح الفكاهة، أليس أصل الروح ضحكة إلهية! في قصة النبي إبراهيم، كما جاء في التوراة، تأتي كلمة: (ضحك) بأحد المعاني بــ (الحيض)، فعندما بشّرت الملائكة زوجة النبي إبراهيم سارة بأنّها حامل: “ضحكت!” والتي تحمل معنيين الأول: لأنّ بشارة الملائكة كانت أقرب للنكتة بالنسبة للعجوز التي قطعتها عادة النساء وأصبحت في سن اليأس، فمن أين لها أن تحمل؟ والثانية تتشاكل مع الأولى: بأنّ سارة قد حاضت، وبالتالي أصبح رحمها جاهزًا للتلقيح وضحكها هنا؛ بمعنى فرحها بالنعمة الإلهية. ومن هذه الواقعة أصبح اسم الطفل: إسحاق/ الضحك/ ضَحك الإله. قد نحتاج لأسطورة أبعد في التاريخ لنفسر بأنّ الضحك يعني: الخلق. يذكر باسكال كنيار في كتابه: (الجنس والفزع) بأنّ هاديس، إله العالم السفلي/ الموت، قد خطف الفتاة بيرسفوني ابنة آلهة الأرض ديمتير، فحزنت عليها حتى أقحلت الأرض، فما كان من إحدى الكاهنات إلّا أن رفعت ثوبها أمام ديمتير، فبان عضوها التناسلي، فضحكت ديمتير وعادت الحياة إلى الأرض. إذن الضحك فعل خلقٍ من قبل الآلهة القديمة، وليس غريبًا أن يكون الربيع ضحكة مجلجلة لآلهة الأرض ديمتير، وليست الأسطورة الفرعونية التي تتكلّم عن الخلق بواسطة الضحك دعابة سوداء، بل دعابة إلهية جديّة جدًا.
واستنادًا إلى ما سبق سنبحث في أساطير القدماء عن ضحك الآلهة! في الأسطورة الإغريقية هناك إله مختص بالضحك اسمه(4): (جيلوس) وهذا إله من النسق الثاني بعد الآلهة الرئيسية كزيوس وهيرا وهو من مرافقي ديونيسوس/ إله الخمر والمجون، يكمن دوره في جعل حفلات الشراب يعمّها الفرح والضحك حتى أنّهم يقهقهون في وسط الحروب، بل يصل بهم الضحك إلى حد المعاناة. ولقد كان جيلوس يُعبد في إسبارطة مدينة الحروب والحكم العسكري، فالجندي الإسبارطي كان مشهورًا بقهقهاته وسط ضرب السيوف وطعن الرماح، فبهذه الطريقة يطرد خوف الموت من قلبه ويثبت شجاعته وبأسه أمام الأعداء، وكأنّنا مع مقولة المتنبي في مدح سيف الدولة الحمداني الذي يشبه الإسبارطيين: تَمُرُّ بِكَ الأَبطالُ كَلمى هَزيمَةً
وَوَجهُكَ وَضّاحٌ وَثَغرُكَ باسِمُ.
وكان يرافق هذا الإله إلهًا آخر اسمه: (كوموس) هو مختصّ بالشراب والمجون، وإلقاء النكات التي تجعل الجميع يضحكون. ينعكس تواجد آلهة للضحك في الثقافة الإغريقية على تقسيم المسرح لديهم، فالتراجيديا يختصّ بها آلهة القدر والمصائر التي لا فكاك منها مهما كانت مأساوية، أمّا الكوميديا، فلها آلهتها التي تبثّ الضحك والفرح والسعادة، وكأنّ اليونانيين قد وزّعوا حياتهم بين ساعة الفرح وساعة الحزن؛ وجهي المسرح: الضاحك والباكي. لا يختلف الرومان عن الإغريق، فنجد لديهم إلهًا للضحك اسمه: (ريسوس).
وإذا توجهنا نحو الشمال الأوروبي في البلاد الإسكندنافية سنجد الإله(5) (لوكي) وهو شقيق إله الرعد (ثور) صاحب المطرقة المشهور في سلسلة أفلام مارفل. كان لوكي يعتبر إله المكر والخداع، ومن الضرورة أن يرافق الضحك تصرفاته؛ وخاصة عندما يشاهد المخدوع وهو يقع في فخّه. تقدّم لنا الأسطورة الإسكندنافية تساؤلًا جوهريًا عن استحالة ضحك الآلهة، لهذا عندما تأتي الإلهة: (سكادي) إلى البنثيون الإلهي الإسكندنافي طالبة الثأر لمقتل أبيها، وتحدتهم أن يجعلوها تضحك، وإلّا فإنّ الدمار والموت سيكون من نصيب مجمع الآلهة. قد يبدو ظاهريًا أنّ طلب سكادي أحمقًا، لكنّه يقع في صلب المعتقدات التي لا ترى في الضحك صفة من صفات الآلهة، وبالتالي يصبح طلبها مستحيل التنفيذ، لكنّ لوكي ينفّذ حماقة، بأن يربط كيس صفنه بحبل إلى رأس معزاة، حيث يتناوبان الشدّ، بين صراخ لوكي من الألم وصراخ الماعز، إلى أن يسقط ملتويًا من الألم في حضن الإلهة سكادي التي تضحك على هذا الجنون؛ هكذا أنقذ لوكي البنثيون الإسكندنافي من الدمار بقيامه بما كان يعتبر مستحيلًا بأنّ تصبح صفة الضحك إحدى صفات الألوهة.
إذن لم يكن ضحك الآلهة منفيًا بالمطلق في الأساطير، بل إنّها تسخر به من أحد أفراد أسرتها. لقد كان هيفيستوس إله الحدادة الإغريقية وكان عبقريًا في صناعة الأدوات كصاعقة زيوس والرمح بالشعب الثلاث لإله البحر بوسيدون ومع ذلك أصبح مدار سخرية الآلهة بسبب عرجه. عندما كان هيفيستوس طفلًا دافع عن أمه الغيورة هيرا أمام أبيه زيوس الكثير العلاقات، فما كان من زيوس إلّا أن طرده بالصواعق، فأصابت إحدى رجليه صاعقة أورثته العرج الذي كان مدار سخرية وتهكّم وضحك من قبل الآلهة الآخرين، فلأول مرة سيكون هناك إله مصاب بعاهة بين الآلهة. لم تتوقّف مأساة هيفيستوس عند هذا الحدّ، فعندما تصالح مع أبيه زيوس وعاد إلى السماء لم تستطع أمه هيرا احتمال وجوده، فتم طرده من جديد، مع أنّه كان السبب في انتصار آلهة الأوليمب في صراعهم ضد العمالقة، ياللمفارقة!
تعتبر إحدى نظريات الضحك، بأنّه عبارة عن استهزاء من الخصم، بل وتقريعه على تحديه للنظم القارة. في أسطورة أورفيوس الموسيقي الذي كان عزفه يبكي الصخر، لم تتركه الأقدار المأساوية يبتهج بحياته، فخطف الموت زوجته يوريدس، وعلى أثر ذلك طفق أورفيوس يغني ويعزف أشجى الألحان حتى رقّ قلب ملك الموت هيدس وزوجته بيرسفوني عليه، وسمحا بأن ترجع يوريدس من العالم السفلي إلى الحياة، لكنهما اشترطا أن لا ينظر أورفيوس إلى زوجته وهو يخرجها من العالم السفلي. لم يستطع أورفيوس أن يفي بهذا الشرط، فنظر ليتأكّد من أن زوجته تلحق به في الممر الصاعد من العالم السفلي، فهل فعل ذلك بسبب الشوق أو لانعدام ثقته بآلهة تخطف البشر من حيواتهم بالموت؛ خبط عشواء؟ لم يعد مهمًا مادار في فكر أورفيوس، فبينما كانت يوريدس تهوي من جديد إلى عالم الموتى كانت أصوات ضحكات هيدس وزوجته بيرسفوني تتردّد في أذني أورفيوس؛ ياللعجب أليست بيرسفوني هي ابنة ديمتير التي أقحلت الأرض بسبب حزن أمها عليها! ولولا الكاهنة (بوبو) التي استطاعت أن تضحك ديمتير لكانت الأرض منذ زمن بعيد قاحلة لا أثر فيها للحياة، ولا لقصة أورفيوس ويوريدس!
تمتلئ أساطير القدماء بضحك الآلهة، حتى من الممكن أن ننعتهم بالضاحكين. وإذا يممنا شطر وجهنا نحو الأساطير الهندية نجد الضحك الإلهي من أجل توطيد العلاقات الأسروية (6). كانت الإلهة (لاكشمي) زوجة كبير آلهة المجمع الإلهي تتأمّل زوجها (فيشنو) الغارق في تأمّله اللانهائي، حيث سحرتها الألف جوهرة التي تزيّن تاجه؛ وهنا رأت ألف وجه امرأة أخرى، فدبّت بها الغيرة وأنّبت زوجها على عشقه غيرها، لكن بعد هنيهة تعود إلى رشدها عندما تدرك بأنّ تلك الصور، ما هي إلّا انعكاس لوجهها، فتوقظ زوجها من تأمله اللانهائي ليضحكان معًا. وفي قصة أخرى يتساءل الطفل الإلهي (جوها) عمّا يوجد بين يدي أبيه المتأمّل، فتخبره أمّه لاكشمي بأنّه يخبئ فاكهة العنّاب، مع أنّها تعرف بأنّ لا شيء بين يدي زوجها فيشنو المتأمل. تزداد حشرية الطفل جوها، فلا تمانع أمّه من أن يرى ماذا يخبئ أبوه بين يديه، وعندما يفتحهما يستيقظ فيشنو ليضحك من حماقة ابنه ولتقول الزوجة بطريقة أقرب للدعاء، بأن يحمي فيشنو ابنه من ضحكته المتفجرة.
أراد بوذا أن يعرف سبب معاناة البشر، وعندما استنار اكتشف السبب، لكن هل ضحك بوذا بسبب أن العالم المادي/ المايا، هو مجرد وهم، وعلى الإنسان أن يعلو على وهم الوجود ليصل إلى النيرفانا. عادة ما يرسم بوذا أو ينحت بابتسامة خفية على وجهه، لكن كهنة مذهب الزن تساءلوا: هل ضحك بوذا على وهم العالم بعد الاستنارة؟ (7). يذهب أتباع بوذا للقول بأنّه قد كان هناك شبح ابتسامة على وجهه، إلّا أنّ كهنة الزن رؤوا غير ذلك! لقد صوروا بوذا ضاحكًا تنتشر قهقهاته في أرجاء الكون، فضحك بوذا هو حالة من التحرّر من التوترات الداخلية إلى الانسجام الكامل مع الكون. بوذا لا يضحك على نفسه أو على الآخرين، فهو لا يضحك لأنّه اكتسب شيئًا لا يملكه الآخرون. إنّ ضحك بوذا، ليس ساخرًا أو مريرًا أو متحديًا. إنّها ضحكة الرحمة، وهي متعة التفاعل بين المعرفة والجهل، التي تشكّل أفراح وأحزان ما نسميه الحياة.
إنّ ما سبق يؤسّس الأرض الشرعية للفكاهة والدعابة والنكتة في الثقافة الإنسانية، حيث كان الضحك هو العكاز الذي يستند عليه الإنسان في تحمّل مشاق الحياة؛ ولو كانت ردّة فعل سيزيف على تدحرج حجره في كل مرّة إلى أسفل الوادي: الضحك! لهانت عليه العقوبة أو لربما وجد حلًا، فكثيرًا ما كان الضحك ينجي من الموت ويرفع العقوبة. إنّ تخيّل الآلهة تضحك من قبل الإنسان لم يكن المقصود منه التقليل من عليائها، بل لأنّ الآلهة كانت دومًا المثال الذي يحتذى به، ممّا يسمح للضاحكين أمام مشاق الحياة أن يقولوا للمتجهّمين المتعصبين: رويدكم قليلًا، فإذا كانت الآلهة تضحك، فمن أنتم حتى تحرمونا من لحظة الفرح العابرة هذه!
إنّ الإنسان يحتاج الضحك حتى يكون قادرًا على احتمال حياة تنتصب بين مجهولين: الولادة والموت. ولا ريب أنّ الضحك قد تطوّر مثله مثل المشاعر الأخرى من حزن وحب وغضب لدى الإنسان، كي يكون قادرًا أكثر على التأقلم مع وجوده المؤقّت على هذه الأرض. وإن نزعه من دخيلة الإنسان سيحرمه من قوى لم تكتشف كليّة بعد، لكن من الممكن استشعارها بالمقولة القديمة: “شرّ البلية ما يضحك!” لذلك يقول نيتشه: “فإنّه لما كان الإنسان هو أعمق الموجودات ألمًا، فقد كان لابد له من أن يخترع الضحك”.
المصادر:
فلسفة الفكاهة – تيري إبغلتون، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت 2029.القرد العاري- ديزموند موريس، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية 1984.الفكاهة والضحك- د. أحمد أو زيد، مجلة عالم الفكر العدد 315، المجلد الثالث عشر 1982.God of Laughter: Gelos in Greek mythology and other similar gods. (ancient-literature.com)Loki – Norse Mythology for Smart People (norse-mythology.org)https://nikhiletc.wordpress.com/2017/12/18/hasya-and-hinduism/Decoding Mythology: The Monk’s Laughter | Buddhistdoorباسم سليمان
كاتب سوري
خاص ضفة ثالثة

باسم سليمان's Blog
- باسم سليمان's profile
- 24 followers



