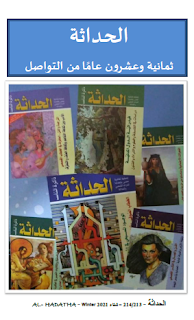مجلة الحداثة's Blog: مجلة الحداثة - Al Hadatha Journal, page 23
March 19, 2021
نحو معجم لغوي عربي من دون "أخطاء" - مختارات من هفوات "المعجم الوسيط" وعيوبه
 ♦ د. عماد بسام غنوم*
♦ د. عماد بسام غنوم*- نبذة عن البحث:
لا بد من أن نشير في البداية إلى أن هذا البحث لا يسعى إلى الانتقاد الهدام، بل إلى البحث عن العيوب والثغرات بهدف معالجتها، للنهوض بالمعجم العربي، وتذكير بأهميته ودوره، حيث إنّ أهم عنصر من عناصر الحفاظ على لغة ما وتأمين استمراريتها وتطورها وتفاعلها مع العصر والحياة، هو المعجم الذي يمثّلها ويجمع ألفاظها ويضبط قوانينها.وقد وضع العرب في القديم، الكثير من المعاجم منها الطويل الموسّع، ومنها الموجز المختصر، إلاّ أنّ هذه المعاجم لم تعد صالحةً اليوم للتعبير عن حاجات العرب، ولا تواكب لغتهم، فهي لم تتفاعل مع الألفاظ التي دخلت إلى العربية من اللغات الأخرى، فجمّدت بذلك اللغة العربية وجعلتها "لغة موت" لا لغة حياة وتجدد.عندما بدأ عصر النهضة في القرن الثامن عشر، هبّ اللغويّون العرب، لوضع "معجم" حديث يواكب حياتهم ويعبّر عن حاجاتهم ويتفاعل مع سائر اللغات التي تفاعل معها العرب حضاريًّا. وقد ظهرت محاولات عدة لإخراج "معجم" يفي بهذه الشروط، نذكر منها: محيط المحيط لبطرس البستاني (1819- 1883)، وأقرب الموارد في الفصيح والشوارد لسعيد الشرتوني (1849- 1912)، والمنجد للأب لويس المعلوف (1867- 1946)، والمرجع لعبد الله العلايلي (1914 – 1996)، والرائد لجبران مسعود (1930)، والمعجم الوسيط لمجمع اللغة في القاهرة.إلا أنّ هذه المعاجم على كثرتها وتنوعها ظلت غير وافية بحاجات اللغة العربية، وقاصرة عن تقديم "معجم" كامل للمثّقف العربي، كما أنّها عجزت عن مواكبة العصر في مختلف ميادينه. وذلك رغم جهود مؤلّفيها وحرصهم على إخراجها على أكمل وجه، وربما عاد سبب فشلهم في ذلك إلى تمثلهم المعاجم الغربية ولا سيما الفرنسية منها؛ فالعربية لا تتوافق مع غيرها من اللغات في الشكل والبناء والتركيب والاشتقاق، ولا بد من مراعاة قوانينها الخاصة في وضع أي" معجم" حتى يكون ناجحًا ومعبرًا عن العربية أصدق تعبير.وعلى الرغم من هذا الواقع، فإن التأليف المعجمي العربي قد توقف منذ أكثر من ثلاثة عقود، ولم تقم بعد محاولة اللغويين اللبنانيين في النصف الثاني من القرن الماضي، أي محاولة جدية لوضع معجم تاريخي للغة العربية، أو حتى محاولة تطوير معجمي لإدخال الألفاظ الجديدة الطارئة في عصرنا، خصوصًا في مجال الاختراعات والتكنولوجيا.
* باحث لبناني - دكتور في كلية الآداب والعلوم الإنسانية – الجامعة اللبنانية.
الحداثة - 213/214 – شتاء 2021 AL- HADATHA - winter
أثر اللغة العربية في " الو لوفية " ودوره في بناء مناهج تعليمها لغير الناطقين بها - على المستوى الصوتي والدلالي
- نبذة عن البحث:
تعدّ اللغة العربية من أسرة اللغات السامية القديمة، وقد مرّت بمراحل وأطوار مختلفة قبل أن تستقرّ على حالها الأخيرة، وازداد من خلال تاريخها الطويل، عدد حروفها، وأصواتها، وثراؤها اللغوي تبعًا لتعدد لهجاتها، كما أن بعض أصواتها قد تغيرت واختلفت طريقة نطقها؛ فمثلاً: حرف الضاد في الفصحى القديمة يختلف اختلافا جوهريًّا عن الضاد الشديدة الشائعة الآن حتّى على ألسنة قُـرّاءِ القرآن الكريم. وهذا الحرف لا يوجد في اللغة "الو لوفية" وربما العديد من اللغات الأخرى، لذا توصف العربية بلغة الضاد، لانفرادها به. ولما جاء الإسلام حفظ العربية وكساها بجمال الأسلوب، وقوّة العبارات، وجزالة الألفاظ، لأن القرآن والحديث منزلان بها؛ وهما المصدران الأساسيان للتشريع الإسلامي، وبسببه تعلقت الشعوب الإسلامية، غير العربية، بتعلم اللغة العربية لفهم الدين الإسلامي.وعملية التعليمية ــ التعلمية للناطقين بغير العربية؛ تعتمد في سهولتها أو صعوبتها على ما يتوفر من سمات وخصائص نفسية ولغوية واجتماعية وثقافية وغيرها مما يقرب الشقة ويسهل الأمر.مشكلة البحث: تكمن مشكلة الدراسة في أن بناء المناهج الدراسية للناطقين بغير العربية يحتاج إلى أسس تتلاءم مع نوعية الدارسين ووضعيتهم وهي: الأسس اللغوية والنفسية والثقافية، لينطلق منها مؤلفو نصوص المناهج اللغوية والكتب المدرسية خاصة. وبما أن دارسي اللغة العربية في إفريقيا جنوب الصحراء عامة والسنغال خاصة، ليست اللغة العربية لغتهم الأصلية فإنهم يواجهون صعوبات جمّة في هذا الاتجاه، عند الشروع في بناء مناهج دراسية مناسبة لهم، مع العلم بأن كتب تعليم اللغة المقررة في المدارس العربية، تأتي من العالم العربي، وهي عادة تؤلف لأبناء العرب الذين لهم ثروة لغوية مناسبة لتلك الكتب، بخلاف أبنائنا في إفريقيا.ولتخفيف هذه المشكلة يرى الباحث ضرورة اللجوء إلى استقصاء الكلمات العربية المقترضة في اللغات الإفريقية لتكون منطلقًا لغويًّا وثقافيًّا ونفسيًّا لتأليف الكتب المدرسية. وهذا ما تبحثه هذه الدراسة التي تعدّ واحدة من الجهود الرامية إلى تحقيق رغبات دارسي اللغة العربية من غير العرب في هذا المجال.فالمقصود بالأسس هنا، أسس بناء منهج اللغة العربية لغير الناطقين بها؛ فقد تم تحديد هذه الأسس على أساس أن عملية التعليمية- التعلمية، تتطلب معلمًا، ومتعلمًا، ومادة تعليمية، ثم وسطًا يتم فيه التعلم. ولما كان المعلم هو القائم بهذه العملية، ودوره توجيه المتعلم، ومساعدته على اكتساب الخبرات الجديدة، وبالتالي فليس هو المستهدف من تلك العملية، ومن ثم فإن العناصر الثلاثة وهي: المتعلم، والمادة التعليمية، ثم الموقف التعليمي، وهي المنابع الأساسية لتلك الأسس، والقاعدة التي لا غنى عنها، لأي خبرة تعليمية- تعلمية أو هي "المصادر الأساسية للمعلومات اللازمة لتخطيط المنهاج". فإذا أهملنا تلك المصادر، فإن النتيجة ستكون وجود مناهج لا تتفق وطبيعة التلاميذ واحتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية، وخاصة في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.
* متخصص في المناهج الدراسية وطرائق التدريس- أستاذ محاضر وباحث مكون في كلية علوم وتقنيات التربية والتكوين التابعة لجامعة شيخ أنتا جوب بدكار السنغال ((Université De Cheikh Anta Diop
الحداثة - 213/214 – شتاء 2021 AL- HADATHA - Winter
سيمياء الصّراع في شعر فؤاد دهينيّ - قصيدة "وطن المجانين" أنموذجًا
ملخّص الدّراسة: يهدف البحث إلى تقصّي العلامات السّيميائيّة في شعر الشاعر اللبناني فؤاد دهيني **، وذلك من أجل تبيان حال اللّبنانيّ وتمظهر علاقاته مع السّلطة الحاكمة، إذ يظهر الشّاعر هذا الصّراع بين المواطن والحكّام، ويقدّم مقاربة لحاله كما حال كلّ مواطن مهما كانت انتماءاته، لذا حاولنا أن نرصد تشكّل صورة الوطن الحقيقيّة الّتي ينظر إليها كلّ لبنانيّ، وصورة الوطن في ظلّ السّياسات المتّبعة كما هو الواقع، ونتساءل هنا: كيف تشكلّت هاتان الصّورتان؟ وكيف أدّت العلامات دلالاتها في تمظهر الواقع اللّبنانيّ وعلاقته بالواقع العربيّ؟ وكيف تجلّت علاقته بمحيطه؟ ما الدّافع الّذي يحتّم على لبنان هذا الاتّصال بالمحيط العربيّ؟ وأين برزت دعوة الشّاعر إلى تجاوز الاختلافات للارتقاء إلى وطن بمعناه الحقيقيّ؟لقد اعتمدنا في هذه الدّراسة آليّات المنهج السّيميائيّ، لمعالجة هذا الموضوع، وقد برزت النّتائج من خلال ترابط المستويات في ما بينها، وعليه فإنّ هذا التّرابط كان له دور ناشط في تبيان كيفيّة تشكّل الواقع اللّبنانيّ، وانعكاس هذا الواقع بمأساويّة على حيثيّات التّفكير عند المواطن.
- الكلمات المفتاحيّة: فؤاد دهيني، السّيميائيّة، وطن، الصّراع، الخبز، السّلطة، السّلاطين، المواطن، الاحتلال، فلسطين، سوريا، القهر، التّوطين، شباط، تشرين.***- Résumé: La recherche vise à enquêter sur les signes sémiotiques dans la poésie de "Fouad Dahini", afin de clarifier la situation du Libanais et ses relations avec le pouvoir, ainsi le poète montre cette lutte entre le citoyen et les dirigeants, et fournit un approche de sa situation comme c'est le cas pour chaque citoyen quelles que soient ses affiliations, nous avons donc essayé de surveiller la formation de la vraie image de la patrie que tout Libanais regarde, et l'image de la patrie à la lumière des politiques poursuivies telle quelle, et on se demande ici: comment ces deux images se sont-elles formées? Comment les signes ont-ils joué leur signification dans l'émergence de la réalité libanaise et sa relation avec la réalité arabe? Comment sa relation avec son environnement s'est-elle manifestée? Quel est le but qui pousse le Liban à se connecter avec le monde arabe? Et d’où vient l’appel du poète à transcender les différences pour monter au vrai sens de la patrie?Nous avons adopté dans cette étude les mécanismes de la méthode sémiotique, en espérant pouvoir répondre à ces questions, et les résultats ont émergé grâce à l'interconnexion des niveaux entre eux, et par conséquent, cette interconnexion a joué un rôle actif en montrant comment la réalité libanaise s'est formée, et comment cette réalité s'est tragiquement reflétée sur la pensée du citoyen.
- Mots clés: Fouad Dhaini, la sémiotique, patrie, conflit, le pain, le pouvoir, les sultans, le citoyen, l'occupation, Palestine, Syrie, subjugation, colonisation, février, octobre
**** تعدّ أطروحة دكتوراه في اللغة العربية وآدابها – المعهد العالي للدكتوراه – الجامعة اللبنانية** شاعر لبنانيّ من بلدة طورا في الجنوب، أستاذ في التّعليم الثّانويّ الرّسميّ، له ديوان (أوراق من عبير)، وديوان (وطن على حافّة القصيدة)
الحداثة - 213/214 – شتاء 2021 AL- HADATHA - Winter
ملامح الفكر المقاوم في الشّعر العاملي - نماذج مختارة
نبذة عن البحث:تولد المقاومة مع الإنسان وتظلّ ملازمة له، لأنّه مخلوق مقاوم بطبعه وفطرته لكلّ ما يحسبه عنصرًا يعمل ضدّه، وللظروف الّتي تحيط به دور فاعل في تعزيز قدرته على المقاومة بشتّى الوسائل الّتي يراها ملائمة. ومن هذه الوسائل "المقاومة الثّقافية" الّتي تأخذ حيزًا مهمًا في إرساء المفاهيم القيميّة الاجتماعية المرتبطة بالمواجهة والتّصدي عند الشّعوب، وفي ترسيخ الفكر المقاوم عندها، والدّفاع عن حقوقها وأرضها وممتلكاتها، وهي تشكّل حافزًا وداعمًا للمقاومة بالسّلاح. وهذا ما أشار إليه الأديب الفلسطيني غسّان كنفاني عندما تحدّث عن القاعدة الثّقافيّة الّتي تؤسّس للمقاومة، كاشفًا العلاقة بين السّياسة والثّقافة، كما بين البندقيّة والفكر، حيث يقول في مقدمة مؤلفه "الأدب الفلسطيني المقاوم تحت الاحتلال 1948- 1968": "ليست المقاومة المسلّحة قشرة، هي ثمرة لزرعة ضاربة جذورها عميقًا في الأرض".من هنا يمكن القول إن الشّعر ليس منسلخًا عن الثّقافة؛ فهو من مركباتها الّتي تجمع بين الّلغة والتّجربة والعاطفة، "وهو خلاصة التّجارب الإنسانيّة، وهو مصدر المعارف الإنسانيّة، ووعاء ثقافي لا غنى عنه، لهذا قال إبن قتيبة "الشعر معدن علم العرب وسفر حكمتها ومستودع ايامها"، أي أنّهم جعلوا الشّعر وعاء لتجاربهم، وحكمهم، وعلومهم، ومعارفهم، وثقافتهم.وبما أن دراسة البنية الفكريّة والثقافيّة والاجتماعية للشّعوب مرتبطة مباشرة بعلم الانثروبولوجيا (Anthropology)، فإنّ هذه الورقة البحثيّة تعالج موضوع الفكر المقاوم في قضايا الشّعر العاملي الاجتماعية، معتمدةً المنهج الوصفي الّذي يبحث في تحليل الواقع وتفسيره وتصويره بأسلوب رمزي. وقد عمدنا إلى طرح مفهوم الفكر المقاوم وتحليله في ضوء نّماذج شّعرية مختارة لشعراء من جبل عامل خلال الفترة الزمنية الممتدة بين العامين 1975-2000.
* كاتبة من لبنان
الحداثة - 213/214 – شتاء 2021 AL- HADATHA - Winter
في حركية مفهوم الشعر العربي وتصدعاته - مقاربات في نماذج تنظيرية مختارة
 ♦ د. كامل فرحان صالح *
♦ د. كامل فرحان صالح *نبذة عن البحث:
يمكن القول إن مفهوم الإبداع الشعري العربي من ناحية الشكل، قد استقر في الوقت الحاضر، على تعريف شبه جامع، يلحظ السمات الآتية:
· الكلاسيكي: ويمكن تعريفه بالكلام المقيّد بالوزن والقافية والذي يقصد به الجمال الفني، وشكله ثابت.
· الحديث (التفعيلة وقصيدة النثر): كل شعر لا يلتزم الوزن والقافية، وشكله يتغير مع تغير كل نصّ.
· النظم: هو الكلام المقيد بالوزن والقافية، لكنه قد يخلو من الجمال الفني.
لكن، هذه التعريفات وإن بدت بسيطة، وواضحة هنا، فقد أخذت مسارًا طويلاً من الوقت، إن كان على مستوى تعريف الشعر العربي شكلاً، أم مضمونًا. وإن كان المسار الطبيعي لسياق أي شيء في العموم، يلحظ محطات متسلسلة، ومتباينة في كثير من الأحيان، إلا أن اللافت في "الشعر"، أن المقاربة القديمة، لا تزال مستقرة، بل يلحظ المتابع أن هذه المقاربة، قد قفزت قفزات أفقية على مقاربات سجلها التراث النقدي العربي، كان يمكن لها أن تشكل مسارًا يغني مفهوم الشعر ونظرياته حديثًا، لو جرى النظر إليها نظرة فاحصة، وفي العمق، بهدف طرحها ضمن سياق تاريخ الشعر العربي وفاعليته.لكن، قد بدا واضحًا، أن مرحلة الانقطاع عن الفعل الحضاري في ما يسمّى "عصر الانحطاط"، قد فعلت فعلها في عرقلة سياق مفهوم متقدم للشعر العربي، إذ كان البارز في ذاك العصر، هو التركيز على العمل الموسوعي، بهدف حفظ الذاكرة العربية من الضياع، وليس العمل الإبداعي الجديد. وهذا ما أدى لاحقًا، إلى أن يُربط مفهوم الشعر العربي الحديث، بسياقات أجنبية، تلحظ فاعلية التجدد في المقاربة الشعرية.يقارب البحث في ما يأتي، إذًا، حركية مفهوم الإبداع الشعري العربي قديمًا وحديثًا (أي إلى حدود ما يسمّى "عصر النهضة")، فيختار نماذج نقدية تعدّ الأبرز على مستوى تناول هذا المفهوم وأبرز خصائصه وسماته.ويهدف البحث من ذلك، إلى أن يضع هذه المقاربات للمفهوم الشعري، ضمن سياق زمني تصاعدي، بهدف تبيان المسارات العربية المؤسٍّسة التي كان يمكن لها أن تستمر وتشكل تغيرًا في النظرة إلى بنية الشعر العربي وخصائصه، بمعزل عن أهمية تأثير الإبداع الأجنبي اللاحق في التجارب الإبداعية العربية، والتأثير الفاعل لدرسه النقدي في هذا الخصوص.
* أستاذ في الجامعة اللبنانية - kamel farhan saleh
الحداثة - 213/214 – شتاء 2021 AL- HADATHA - Winter
في حركية مفهوم الشعر العربي وتصدعاته ( مقاربات في نماذج تنظيرية مختارة )
 ♦ د. كامل فرحان صالح *
♦ د. كامل فرحان صالح *نبذة عن البحث:
يمكن القول إن مفهوم الإبداع الشعري العربي من ناحية الشكل، قد استقر في الوقت الحاضر، على تعريف شبه جامع، يلحظ السمات الآتية:
· الكلاسيكي: ويمكن تعريفه بالكلام المقيّد بالوزن والقافية والذي يقصد به الجمال الفني، وشكله ثابت.
· الحديث (التفعيلة وقصيدة النثر): كل شعر لا يلتزم الوزن والقافية، وشكله يتغير مع تغير كل نصّ.
· النظم: هو الكلام المقيد بالوزن والقافية، لكنه قد يخلو من الجمال الفني.
لكن، هذه التعريفات وإن بدت بسيطة، وواضحة هنا، فقد أخذت مسارًا طويلاً من الوقت، إن كان على مستوى تعريف الشعر العربي شكلاً، أم مضمونًا. وإن كان المسار الطبيعي لسياق أي شيء في العموم، يلحظ محطات متسلسلة، ومتباينة في كثير من الأحيان، إلا أن اللافت في "الشعر"، أن المقاربة القديمة، لا تزال مستقرة، بل يلحظ المتابع أن هذه المقاربة، قد قفزت قفزات أفقية على مقاربات سجلها التراث النقدي العربي، كان يمكن لها أن تشكل مسارًا يغني مفهوم الشعر ونظرياته حديثًا، لو جرى النظر إليها نظرة فاحصة، وفي العمق، بهدف طرحها ضمن سياق تاريخ الشعر العربي وفاعليته.لكن، قد بدا واضحًا، أن مرحلة الانقطاع عن الفعل الحضاري في ما يسمّى "عصر الانحطاط"، قد فعلت فعلها في عرقلة سياق مفهوم متقدم للشعر العربي، إذ كان البارز في ذاك العصر، هو التركيز على العمل الموسوعي، بهدف حفظ الذاكرة العربية من الضياع، وليس العمل الإبداعي الجديد. وهذا ما أدى لاحقًا، إلى أن يُربط مفهوم الشعر العربي الحديث، بسياقات أجنبية، تلحظ فاعلية التجدد في المقاربة الشعرية.يقارب البحث في ما يأتي، إذًا، حركية مفهوم الإبداع الشعري العربي قديمًا وحديثًا (أي إلى حدود ما يسمّى "عصر النهضة")، فيختار نماذج نقدية تعدّ الأبرز على مستوى تناول هذا المفهوم وأبرز خصائصه وسماته.ويهدف البحث من ذلك، إلى أن يضع هذه المقاربات للمفهوم الشعري، ضمن سياق زمني تصاعدي، بهدف تبيان المسارات العربية المؤسٍّسة التي كان يمكن لها أن تستمر وتشكل تغيرًا في النظرة إلى بنية الشعر العربي وخصائصه، بمعزل عن أهمية تأثير الإبداع الأجنبي اللاحق في التجارب الإبداعية العربية، والتأثير الفاعل لدرسه النقدي في هذا الخصوص.
* أستاذ في الجامعة اللبنانية - kamel farhan saleh
الحداثة - 213/214 – شتاء 2021 AL- HADATHA - Winter
دور تماسك أسرة الأهل في نشوء نزاعات الحياة الزوجية للأبناء - دراسة إثنوغرافية
· الملخص: هدفت هذه الدراسة** الإمبريقية (Empirical) النوعية إلى بناء إطار فهم لديناميات تشكّل الأسرة اللبنانية الجديدة ونزاعاتها؛ فاعتمدت الطريقة الإثنوغرافية (Ethnography)، واستخدمت المقابلة المفتوحة كأداة لجمع البيانات. أظهرت النتائج أنّ نزاعات الأسر الجديدة تُساق أحيانًا بالنيّات الإيجابية (الحسنة)، وبتأثير تماسك أسرة الأهل. وقد صمّمت مجموعة من النماذج لتظهير تصوّر أذهان أعضاء كل أسرة عن الدينامية الافتراضية والآلية المتخيّلة لتشكُّل الأسرة الجديدة.
***The Role of The Parents Family Cohesion in the Emergence of The Children’s Family Conflicts
· Abstract:
This Empirical qualitative study aimed at building a frame for understanding the dynamics of the new family structure and its conflicts in the Lebanese society. The Ethnographic method was followed and open interviews have been conducted for data gathering. The results showed that new family conflicts are sometimes driven by positive (good) intentions, in addition to the effects of the parent’s family cohesion. Some family dynamics models have been designed to show how these dynamics were imagined in the minds of the family members.
· Keywords: Family structure; Family cohesion; Family dynamics; Family conflicts***
* أستاذ مساعد في الجامعة اللبنانية – كلية الآداب والعلوم الانسانية – قسم علم النفس
** ملاحظة: هذه الدراسة انطلقت فكرتها في إطار المشاركة في مؤتمر: "العمران والتكنولوجيا في الأزمنة المعاصرة" الذي نظمته "جمعية ممارسي النفسعلاج والاستشارات النفسية" بالتعاون مع الجامعة اللبنانية، وقد قُدِّم حينذاك كورقة مشاركة تمهيدًا لمتابعة الاستقصاء الإثنوغرافي الذي انتهى إلى شكله الحالي بعد تطوير النماذج واكتمالها.
الحداثة - 213/214 – شتاء 2021 AL- HADATHA - Winter
دور تماسك أسرة الأهل في نشوء نزاعات الحياة الزوجية للأبناء ( دراسة إثنوغرافية )
· الملخص: هدفت هذه الدراسة** الإمبريقية (Empirical) النوعية إلى بناء إطار فهم لديناميات تشكّل الأسرة اللبنانية الجديدة ونزاعاتها؛ فاعتمدت الطريقة الإثنوغرافية (Ethnography)، واستخدمت المقابلة المفتوحة كأداة لجمع البيانات. أظهرت النتائج أنّ نزاعات الأسر الجديدة تُساق أحيانًا بالنيّات الإيجابية (الحسنة)، وبتأثير تماسك أسرة الأهل. وقد صمّمت مجموعة من النماذج لتظهير تصوّر أذهان أعضاء كل أسرة عن الدينامية الافتراضية والآلية المتخيّلة لتشكُّل الأسرة الجديدة.
***The Role of The Parents Family Cohesion in the Emergence of The Children’s Family Conflicts
· Abstract:
This Empirical qualitative study aimed at building a frame for understanding the dynamics of the new family structure and its conflicts in the Lebanese society. The Ethnographic method was followed and open interviews have been conducted for data gathering. The results showed that new family conflicts are sometimes driven by positive (good) intentions, in addition to the effects of the parent’s family cohesion. Some family dynamics models have been designed to show how these dynamics were imagined in the minds of the family members.
· Keywords: Family structure; Family cohesion; Family dynamics; Family conflicts***
* أستاذ مساعد في الجامعة اللبنانية – كلية الآداب والعلوم الانسانية – قسم علم النفس
** ملاحظة: هذه الدراسة انطلقت فكرتها في إطار المشاركة في مؤتمر: "العمران والتكنولوجيا في الأزمنة المعاصرة" الذي نظمته "جمعية ممارسي النفسعلاج والاستشارات النفسية" بالتعاون مع الجامعة اللبنانية، وقد قُدِّم حينذاك كورقة مشاركة تمهيدًا لمتابعة الاستقصاء الإثنوغرافي الذي انتهى إلى شكله الحالي بعد تطوير النماذج واكتمالها.
الحداثة - 213/214 – شتاء 2021 AL- HADATHA - Winter
Migrant and domestic workers facing socio-economic crisis and COVID-19 in Lebanon
- نبذة عن البحث باللغة العربية:
العمالة الأجنبية في لبنانازاء الأزمة الاجتماعية والاقتصادية وجائحة كورونا
تعاني العمالة الأجنبية في لبنان (العمّال الأجانب والعاملات في الخدمة المنزلية) من ضائقة مالية بسبب الركود الاقتصادي الذي أعقب حركة 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2019، إضافة إلى تدهور وضع الليرة اللبنانية مقابل الدولار و"كوفيد-19" (COVID-19). شُخّصت أول إصابة في لبنان في شباط (فبراير) 2020، وأعلن الإغلاق في 15 آذار (مارس) للحدّ من انتشار سرعة الوباء.
لا تسمح إجراءات الحجر الصحي للعمّال الأجانب والعاملات في الخدمة المنزلية بالعمل من بعد بسبب طبيعة عملهم. إضافة إلى عدم حصولهم على أي مدخول نظرًا إلى حالة الإغلاق التي عاشها لبنان. ما أدى ذلك إلى معاناة الكثيرين منهم وإلى فقدان وظائفهم ودخلهم، وانخفاض أجور البعض منهم جراء عدم تمكن أرباب العمل اللبنانيين من دفع هذه الأجور، بسبب فقدانهم وظائفهم، فوجدوا أنفسهم في وضع حرج غير قادرين على دفع أجور العمالة الأجنبية نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار الذي قدر سعره بـ3900 ليرة لبنانية رسميًّا (بينما لامس 10 آلاف ليرة في السوق السوداء)؛ فبات البعض منهم في حالة يرثى لها.بلغ إجمالي حجم العمالة الأجنبية الشرعية بحسب وزارة العمل، سنة 2018، 270 ألف عامل وعاملة، في حين تتخطى أعداد غير الشرعيين منهم هذا الرقم بأضعاف؛ وبحسب النسب فهم يشكلون 5.5% من النسبة الإجمالية لسكان لبنان (باستثناء اللاجئين الفلسطينيين والسوريين). ووفقًا للتقرير اليومي الذي نشرته وزارة الصحة، فإن 8% من الأجانب مصابين في أيار (مايو) 2020.تهدف هذه الدراسة إلى معالجة أثر قضية "كوفيد-19" الاجتماعي والاقتصادي والصحي على الحياة اليومية للعمّال الأجانب والعاملات في الخدمة المنزلية في لبنان، وكذلك على عودتهم إلى أوطانهم الأم.أما منهجيًّا، نعتمد البحث النوعي في هذه الدراسة عبر مقابلات شبه موجهة مع عمّال أجانب وعاملات في الخدمة المنزلية، وأرباب عمل لبنانيين وخبراء.من أبرز النتائح المتوقعة من هذه الدراسة بناء سياسات اجتماعية لدعم هذه الفئة خلال الأزمات بغية تحصيل حقوقهم والدفاع عنها.
الكلمات المفتاح: العمّال الأجانب- العاملات في الخدمة المنزلية- الأزمة الاجتماعية والاقتصادية- جائحة كورونا- لبنان
***
- Abstract: The migrant and domestic workers in Lebanon are experiencing financial hardship due the economic recession following the uprising of October 2019, the dollar crisis and COVID-19. Lebanon identified the first human case in February 2020, and declared the lockdown on March 15tth to deal with the spread of the epidemic. Confinement measures don’t allow migrant and freelance domestic workers to work remotely due to the nature of their jobs. Additionally, they are being blocked with no source of income since the country is on lockdown and households are quarantined; that has caused many to suffer job and income losses, a reduction or a suspension of their wages as Lebanese employees who have lost their jobs and find themselves in a critical situation and unable to pay migrant workers at a market exchange rate of 4000 LBP; to say the least migrant are in dire situation. Their number is close to 270,000 according to the Ministry of Labor in 2018; this is excluding the irregular labor force that is hard to estimate. The foreign population represents up to 5.5% (excluding Syrian and Palestinian refugees). According to the daily report published by the Ministry of Health, in May 2020, 8% of foreigners are infected.This study aims to address the issue of COVID-19 and its socio-economic and health impact on the daily lives of migrant and domestic workers in Lebanon as well as their return to their home countries.Methodologically, the qualitative approach will be applied for this study realizing in-depth interviews with migrant and domestic workers, Lebanese employees, and experts. The results will shed the light for a possible social policy related to this situation in Lebanon as a way to secure their rights.
Keywords: Migrant- Domestic workers- socio-economic crisis - COVID-19- Lebanon
***
* د. سوزان عادل منعم : أستاذة محاضرة وباحثة في الجامعة اللبنانية، معهد العلوم الاجتماعية، منسقة مختبر "البينمناهجية" في مركز الأبحاث في المعهد، ورئيسة قسم المنهجية والابيستمولوجيا والتقنيات في المعهد (الفرع الثاني). مستشارة في الهجرة الدولية والعلاقات الإثنية. حائزة شهادة الدكتوراه من جامعة Poitiers الفرنسية .(Migrinter) باحثة في المركز اللبناني لدراسة الهجرة والانتشار (LERC) في جامعة سيدة اللويزة منذ سنة 2007، وباحثة في المركز الفرنسي للشرق الأدنى (IFPO) منذ سنة 2011. عضو في الجمعية الدولية لعلم الاجتماع والجمعية اللبنانية لعلم الاجتماع. شاركت تنظيمًا وحضورًا في العديد من المؤتمرات والدراسات ولها العديد من المنشورات.
* Dr. Suzanne Menhem: Assistant Professor & Researcher at the Lebanese University, Institute of Social Sciences. Coordinator at the Laboratory of Interdisciplinary CRSS-Beirut, Coordinator of the Master Program Human Resources at the Lebanese University & Head of Department of Methodology, Epistemology and Techniques. Independent consultant (Experience in different sectors: Social Sciences and Migration). Menhem holds a Ph.D. in Social Sciences with sub-specialty in migration studies from the University of Poitiers (Migrinter) in France. She is a Research Associate with the French Institute of The Near East (IFPO) in Beirut since 2011 and also research associate with the Lebanese Emigration Research Center for Migration and Diaspora studies (LERC) since 2007, she is a member of the International Association of Sociology & of the Lebanese Association of Sociology since 2014. She also organized and participated in several research, conference, workshops and training programs. She wrote and published articles, book section and book.
الحداثة - 213/214 – شتاء 2021 AL- HADATHA - Winter
الحداثة 28 عامًا من التواصل
مجلة الحداثة - Al Hadatha Journal
مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة
تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)
ISSN/2790 Al Hadatha Journal - A Refereed Academic Quarterly
مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة
تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)
ISSN/2790-1785
تُعنى المجلة بنشر الأبحاث الأكاديمية بعد عرضها على لجنة علمية متخصصة. وتبلورت فكرة نشوء المجلة بعد اجتماعات عمل متواصلة بين رئيس تحريرها فرحان صالح وأصدقاء باحثين وأكاديميين من لبنان والعالم العربي، وقد بات عدد منهم ضمن الهيئة الاستشارية للمجلة، علمًا أن بعضهم قد فارق الحياة، وقد جرى إضافة أسماء إلى الهيئة لاحقًا. تغطي مجلة الحداثة الأبحاث التي تأتي من شريحة واسعة من الأكاديميين والمفكرين والكتّاب والأدباء في لبنان والعالم العربي، فتنشر موضوعات تتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والسياسية، كذلك، موضوعات تتعلق بقضايا فكرية وتراثية وأدبية ونقدية وفنية وإعلامية ...more
- مجلة الحداثة's profile
- 11 followers