مجلة الحداثة's Blog: مجلة الحداثة - Al Hadatha Journal, page 21
July 21, 2021
نوافذ: تجربة الاكتفاء الذاتي الناصرية مرجعية لمواجهة التغريب (حوار مع صديقي سعد محيو)
♦ فرحان صالح
يتغير العالم، يتبدل، هناك فوضى عالمية بدأت قبل عهد ترامب، لكنها مستمرة، ومن علامات ذلك أن الامبراطوريات الجديدة المناهضة للولايات المتحدة لم تثبت أقدامها في أي موقع وصلت إليه؛ هذه روسيا في سوريا، الوحود الملتبس والمشروع المبهم، وهذه الولايات المتحدة الأميركية ذاتها تنسحب وتتراجع مهزومة من أفغانستان، وهي تسعى إلى تعزيز حضور القبليات الدينية والعنصرية في أي مكان تحلّ به، بدءًا من أفغانستان، وتستعمل المحيط البشري الإسلامي بشقيه السني والشيعي المحيط بروسيا، والمنسحب من نسيج المجتمعات الإسلامية، قاعدة خدمات لها ولأدواتها، فالقوات الأميركية وهي تنسحب من أفغانستان، تخطط كي تجعل من طالبان أداة متعددة الأهداف، ليس ضد روسيا فحسب، بل لإيجاد توترات مستمرة مع باكستان وايران وصولا للهند أيضًا، ولن تكون الدول الإسلامية المحيطة بروسيا بعيدة من مرماها. وإن كان الهدف الأساسي للولايات المتحدة حصار روسيا ومنعها من التمدد... أيضًا لمنع أية حركة تغييرية في الوطن العربي.ليست النهاية هنا، بل تحاول الولايات المتحدة الأميركية تعزيز أمراضها حول العالم ظنًا منها أنها بذلك تحمي نفسها ومصالحها. تحاول أمريكا محاصرة الصين، وهي دون تاريخ استعماري تستند إليه، من خلال اتفاقات تعاون تجربها أميركا مع الدول المحيطة بالصين، والهدف منع تمدد الصين، وبالتالي الحدّ من تقدمها.أوروبا المستندة إلى تاريخها الاستعماري والملتبس من دون مراجعة له، تحاول إعادة مدّ نفوذها إلى الشرق بدءًا من لبنان. أوروبا هذه التي تعاملها الولايات المتحدة بدونية واصفة إياها بالقارة العجوز، وبالإمبراطورية المريضة هي ما تسعى إلى تجديد سياساتها مع بلدان المشرق دون مراجعة، أو تقييم لماضي علاقاتها مع هذه الدول.هذه النماذج المنافسة والمتصارعة من دون هدف، تحاول أميركا عبرها ومنها صناعة الفوضى وحماية مصالحها، من دون الاكتراث لمصالح دول أخرى، سواء أكانت صغيرة أم كبيرة.تذكر صديقي سعد محيو، بل لنتذكر سويًّا بعض الأصدقاء المعنيين بالتجديد وإعادة المعنى للمشروع السياسي الاجتماعي الثقافي العربي، بخاصة في مصر الذين تعلمت منهم الكثير. فالمشروع الناصري في تاريخيته أصبح مرشدًا وقاعدة لكل التيارات السياسية في مصر والعالم العربي. نشير إلى ذلك ونحن نعلم أن المشروع الناصري كان عالميًّا، ومن أبرز من كانوا شركاء جمال عبد ناصر في ذاك الزمن الرؤساء شكري القوتلي ونهرو وتيتو وماو تسي تونغ وكاسترو وبن بيلا وبومدين، والحبيب بورقيبه وإن اختلفت وجهته عن الآخرين إلا أن مشروعه (العلماني) وبشكل خاص منه التربوي ونظرته لتحرير المرأة، يبقى نموذجًا متفردًا لا يمكن إلا الاعتراف بأنه كان على العرب أن يدرسوه، وينظروا إليه بعين الاعتبار، كذلك عبد السلام عارف وعبد الله السلال وفؤاد شهاب ولوممبا وغيرهم... هذا هو عالم عبد الناصر وهؤلاء هم بعض الشركاء من النخب المشاركة والشريكة في صناعة ذلك العالم وذاك الحلم الذي تحول بفضلهم إلى حقيقة في ذاك الوقت.حلم دول وشعوب عربية وافريقية وأسيوية شكلت حركات التحرر فيها الواجهة، وحملت قياداتها المشروع الذي كان واجهته المشروع المصري، مشروع عبد الناصر. فما كان يطمح له عبد الناصر هو أن يجعل من مصر والوطن العربي كتلة اجتماعية وعنوانًا للتغيير في مجرى التاريخ، محاولاً ومشاركًا في تأسيس الروافد والروافع العربية والافريقية والأسيوية التي تساهم في تحقيق المشروع المصري العربي.بدأ عبد الناصر في خلق محيطه العربي، فكانت باكورة ذلك الوحدة المصرية السورية التي تآمر عليها الكثيرون وفي مقدمتهم الأحزاب السورية، خاصة حزب البعث العربي الاشتراكي السوري الذى انسحبت كتلته برئاسة أكرم الحوراني من البرلمان، كذلك انسحب الحزب الشيوعي رافضًا الوحدة. ومن الطبيعي أن يكون الحزب القومي السوري التي كانت مواقفه واضحة بتحالفه مع قادة حلف بغداد، قد جمعته المصلحة مع الشيوعي والبعثي، ضد الوحدة. لقد تحولت تلك الأحزاب إلى أدوات بيد الخارج، وكانت مطية للأنظمه الرجعية في ذاك الوقت.إن ما يتجاهله من أرخوا لتلك المرحلة، خاصة من هذه الأحزاب، أن سوريا جديدة بُنيت خلال سنوات الوحدة، إذ تم مد شبكة الكهرباء إلى أنحاء القطر السوري، وبُنيت مئات المدارس والمستشفيات والجامعات، ووصل إلى الفلاحين كل ما يحتاجونه من أدوات صُنعت بأيدٍ مصرية سورية، كما شُقّت آلاف الكيلومترات من الطرق التي ربطت المحافظات السورية ببعضها البعض، كذلك مدت شبكات المياه إلى المنازل والمؤسسات، إلى غير ذلك من مشاريع. لقد بُنيت الأرضية الأساسية التي أدت إلى انتقال سوريا من عصر إلى عصر. لقد تقدمت سوريا عشرات السنين عمّا كانت عليه قبل الوحدة، كما كانت مصر عونًا للجزائر لتحريرها من الاستعمار الفرنسي، كذلك حُرر العراق واليمن وليبيا والسودان من الملكية والاستعمار والاقطاعية. بهذا يكون عبد الناصر ساهم في خلق محيطه العربي، وفي خلق المناخات للحوار والتعاون بين الدول والشعوب العربية والإفريقية وبين شعوب أميركا اللاتينية ودول أوروبا الشرقية التي لم تكن بعيدة من هذا الحلم المشروع، تلك الشعوب التي أصبحت كتلة متراصة غير منفصلة عن بعضها، بل أصبح كل منها سندًا للآخر، وخطًّا للدفاع عنه. وكانت الهند شريكة لعبد الناصر في عالمه، كذلك الصين التي لم تكن بعيدة، وإن كانت طموحات قياداتها الراديكلية أكثر غورًا وأبعد مدى. فمصر كانت المدرسة الأولى التي توارثت الصين تجربتها وقلدتها في تصنيع الحاجات البيتية. المشروع الناصري صنّع ما يحتاجه البيت المصري من حاجات، فلم يعد يحتاج إلى أي شيء من الخارج. كان ذلك قبل العام 1970م. لقد صُنّعت كل الحاجات البيتية بأيدٍ مصرية، وهذا ما فعلته الصين التي حولت هذا المشروع من محلي إلى عالمي، وها هي تغزو العالم بأجمعه بهذه الصناعات. أيضًا لم يكن من فواصل بين مصر ودول عدم الانحياز. مشروع عبد الناصر كان مشروع دول عدم الانحياز ذاته، مشروع التحرر السياسي والاجتماعي والثقافي من الاستعمار وعملائه. لقد كانت مصر، من ناحية التطور، تقارع اليابان، بل كانت في وضعية ندية معها متقدمة بذلك عن كوريا الجنوبية كما ذكر كل من سمير أمين وشارل بتلهايم. كذلك يوغسلافيا (تيتو) التي كانت على تعاون مع مصر في مجالات التصنيع العسكري، وكانت حليفة ناصر وشريكته في كل المجالات، وهو ناصر الذي استفاد من خبرات السلاف في التصنيع العسكري.كان الحضور السياسي لعبد الناصر قويًّا جدًا ليس في أميركا اللاتينية فحسب، بل في الولايات المتحدة الأميركية ذاتها مع المهاجرين العرب وغيرهم من المسحوقين ومن الهنود والاميركيين من أصول افريقية، إذ كانوا يعدّون أنفسهم جزءًا من مشروع تمثله مصر وكتلة عدم الانحياز. أصبح المشروع الناصري مشروع كل من يسعى إلى حرية الإنسان والعدالة الاجتماعية.إن الصورة التي رسمها عبد ناصر في مصر والعالم، كانت مثالًا، فقد بدأ في مصر بتحرير الأرض من الاقطاعيين، وبتحرير َمصر من الاستعمار، فالاستعمار والاقطاعيون كانوا حلفاء، وكانوا يتفننون في إذلال الفلاحين، وبالتالي الشعب المصري. لقد رسم ناصر صورة لمصر قائمة على تعزيز الانتماء للأرض وبالتالي للوطن، فكان الإصلاح الزراعي الذي ساهم في تعزيز الانتماء الوطني، قد استفاد منه الفلاحون وهم العنوان الأبرز للتحرر الاجتماعي الذي استكمله عبد الناصر ببناء السد، وبتوظيف الجامع والكنيسة والأزهر كمراكز تعليمية وإعلامية لخدمة مشروعه. لقد تحولت هذه من مؤسسات تخدم الاقطاع والاستعمار إلى مؤسسات للتغيير وتوجيه الرأي العام نحو التحرر. لم تعد هذه المؤسسات منفصلة عن العصر وعن هموم الناس.لقد جعل عبد الناصر من الجامع والكنيسة والأزهر مشاريعَ توجيهية وإعلامية لخدمة مشروعه، خاصة في مكافحة الأمية والتسول والبطالة، إذ منع التسول كما كافح الأمية، فعند وفاته كانت مصر شبه خالية من هذه الآفات، واستفاد من الإصلاح الزراعي ما يزيد على ثلاثة ملايين فلاح ومواطن مصري، أيضًا فتح أعين الأجيال الجديدة على العلوم والتقنيات الحديثة، ولم يكن من كتاب علمي يصدر عن أي مكان من العالم إلا وتكون دور النشر المصرية قد ترجمته ونشرته. بهذا التوجه كان يؤسس ناصر لعقلية علمية مصرية عربية مرتبطة بالعصر، فمن خلال توطين العلوم المعاصرة وجعلها مرجعية ومنهجًا في المدرسة والجامعة، تأسست مناخات مجتمعية مرتبطة بحاجات الإنسان، كما جعل من المنابر الإعلامية ودور النشر مؤسسات تعليمية وتنويرية َمتصلة بحاجات المجتمع، رابطًا إياها بالمدرسة والجامعة وبالتالي بمؤسسات المجتمع، تمامًا كما هي في الدول المتحضرة التي أصبحت فيها العلوم الحديثة مرشدة للعقول. لقد صنعت مصر الطائرة والثلاجة والسيارة بالتعاون مع الهند. وعبر هذه السياسة أصبحت التقنيات الحديثة بين أيدي المصريين، وأصبحت هذه التقنيات بين أيدي المواطن المصري مثله مثل أي مواطن من شعوب العالم المتقدم.عمم عبد الناصر المدارس والجامعات ومراكز الأبحاث، ومد الشبكات الكهربائية إلى كل أنحاء مصر، وأنشأ مئات المصانع والمدارس والجامعات، وحقق مجانية التعليم، كذلك عمم المستشفيات في كل المناطق، وحرر مصر من الاستعمار ومن الاقطاع، وفتح الطرق للمواطن المصري للتغيير، وتحققت أحلام المصريين التي كانت قبل العام 1952 كوابيس. كانت مهمة المدرسة والجامعة التأسيس لبناء مصر الجديدة أيضًا تزويد المؤسسات المصرية بالأطباء والمهندسين والاختصاصيين في مجالات العلوم المعاصرة كافة، ومنها المسرح والسينما والموسيقى وفن الرسم والإذاعة...كان عبد الناصر يضع نصب عينيه رسم صورة لأجيال جديدة وإدارة المؤسسات على تنوعها، وخلق الروافع العلمية البشرية والمادية الممتدة في النسيج المجتمعي المصري من دون توقف، ومن ضمن أهدافه أن يجعل من الريف مكانًا صالحًا للعيش ولسكن الأجيال. ومن مصر مرجعية علمية وبلدًا مكتفيًا ذاتيًّا. لقد أصبحت الصناعات المصرية ماركات عالمية. وعلى الرغم من نكسة العام 1967م، إلا أن مصر أصبحت مرجعًا عالميًّا وقبلة للعلماء، واقتربت من أن تصبح بلدًا مكتفيًا ذاتيًّا.لكن وللأسف، نرى اليوم أن الإعلام والمنظرين على شاشاته، يحاولون تشويه هذا التاريخ الذي صنعته العقول المصرية العربية، وحولته الأيدي والعقول في المصانع والجامعات والمدارس وعلى امتداد الأرض المصرية والعربية إلى واقع. (لقد جاء السادات فحوّل الحلم إلى كوابيس، وعادت مصر في عهده إلى سابق ما كانت عليه قبل العام 1952م وهذا بحاجة إلى دراسة أخرى منفصلة عما نؤرخ له ونشير إليه). لقد تجاهل الإعلام خلال عهدي السادات ومبارك هذه الانجازات، يتجاهل ما حققته العقول المصرية العربية من إنجازات حققها الشعب المصري العربي، الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، وبايعاز من السلطة الحاكمة كانت مهمته تشويه صورة ما كانت عليه مصر في ذلك الزمن.إن ما يقوم به الإعلام غريب ومريب أيضًا؛ يشوّه هذا التاريخ ليجعل الشعب المصري في حالة ضياع، والحجة عدم وجود ديمقراطية في مصر، في حين ان المشروع الناصري كان يخدم ويمثل 90 في المئة من مصالح المصريين. وإن كنا نتساءل عن أية ديمقراطية يتحدثون، فهل كانت أوضاع الشعب الصيني (خاصة لجهة حقوق الإنسان) الاجتماعية والثقافية أفضل مما كانت عليه في َمصر، أو أوضاع الاتحاد السوفياتي أو حتى أوضاع الولايات المتحده الأميركية ذاتها التي منعت نشر كتب هنري ملير، ومنعت توزيع الكتب الشيوعية، كذلك كانت تلاحق الشيوعيين، ولم تسمح في تأسيس أحزاب شيوعية أو... أفضل حالا مما كانت تعرفه مصر؟اليوم أميرکا تزوّر كل شيء، هي من ترسم صورة العالم على قياس مصالحها. ويساهم النظام الرأسمالي في خلق عالم موزييك مشوّه. أميركا تستخدم الطوائف لتنفيذ مشروعها الهادف لبقاء العالم العربي على ما هو عليه من تخلف، وبالتالي لصناعة جبهات وأحلاف طائفية من باكستان إلى أفغانستان إلى السعودية فتركيا. هذه الدول التي يحاول أن يجعل منها وبينها حلفًا سنيًّا في مواجهة ما تم تسميته بحلف "الهلال الشيعي" الذي تتزعمه إیران وتحاول الولايات المتحدة تثبيته، على أن تكون إسرائيل بين هذا وذاك الحكم.لقد رسمت الولايات المتحدة صورة لما تريد أن يعزز سيطرتها، فكانت الأيديولوجيات الدينية التي تمت صناعتها وتجديد مهمتها أمريكيًّا، أن تحولت إلى مشاريع لتفتيت المنطقة، وإلى دويلات يمكن اللعب بها، وجعلها أدوات طيّعة لخدمة مشاريعها، فضلاً عن تغليب الفكر الديني القبلي على الفكر الوطني والقومي.وهنا نلفت النظر إلى نماذج أخرى موجودة وجاهزة للاستعمال، والسؤال عن مهمتها: ما هي مهمة الحرکة الصهيونية، أيضا الحركة الوهابية، أيضا حركة ولاية الفقيه، وأخيرًا الحركة المهزومة حركة الاخوان المسلمين؟ هذه الحركات القبلية التي تستغلها الولايات المتحدة الأميركية وتسعى إلى تحريكها في الوقت المناسب، غب الطلب، ومتی تشاء لحروب أهلية قد تدوم لمئات السنين. إن هذه الحركات التي تسيّرها الولايات المتحدة هي مشاريع مستقبلية، وستكون مصر والجزائر والسودان والسعودية بعضًا من الساحات المقبلة، وهناك أمثلة من الدول التي يعمل بها النظام الرأسمالي ولم يكتمل مشروعه فيها، تتبدى في الصور التي رسمتها لليبيا واليمن والعراق وسوريا والسودان ولبنان، حيث تهدف أميركا إلى تجزئة هذه البلدان وتقسيمها، ومحاولة إعادتنا إلى العصور القبلية. هذا هو هدف الولايات المتحدة الأميركية، وهذا ما ترغب به وتعمل على تنفيذه، وهو ما على شعوب المنطقه الانتباه منه، كما علينا ألا ننسی القواعد الأميركية المنتشرة في غير مكان من العالم، وبخاصة العالم العربي منه، حيث هذه القواعد موجودة لكبح وضرب أي تقدم أو تطور.
*** مجلة الحداثة - ربيع 2021 - عدد 215 /216 - Al Hadatha Journal
يتغير العالم، يتبدل، هناك فوضى عالمية بدأت قبل عهد ترامب، لكنها مستمرة، ومن علامات ذلك أن الامبراطوريات الجديدة المناهضة للولايات المتحدة لم تثبت أقدامها في أي موقع وصلت إليه؛ هذه روسيا في سوريا، الوحود الملتبس والمشروع المبهم، وهذه الولايات المتحدة الأميركية ذاتها تنسحب وتتراجع مهزومة من أفغانستان، وهي تسعى إلى تعزيز حضور القبليات الدينية والعنصرية في أي مكان تحلّ به، بدءًا من أفغانستان، وتستعمل المحيط البشري الإسلامي بشقيه السني والشيعي المحيط بروسيا، والمنسحب من نسيج المجتمعات الإسلامية، قاعدة خدمات لها ولأدواتها، فالقوات الأميركية وهي تنسحب من أفغانستان، تخطط كي تجعل من طالبان أداة متعددة الأهداف، ليس ضد روسيا فحسب، بل لإيجاد توترات مستمرة مع باكستان وايران وصولا للهند أيضًا، ولن تكون الدول الإسلامية المحيطة بروسيا بعيدة من مرماها. وإن كان الهدف الأساسي للولايات المتحدة حصار روسيا ومنعها من التمدد... أيضًا لمنع أية حركة تغييرية في الوطن العربي.ليست النهاية هنا، بل تحاول الولايات المتحدة الأميركية تعزيز أمراضها حول العالم ظنًا منها أنها بذلك تحمي نفسها ومصالحها. تحاول أمريكا محاصرة الصين، وهي دون تاريخ استعماري تستند إليه، من خلال اتفاقات تعاون تجربها أميركا مع الدول المحيطة بالصين، والهدف منع تمدد الصين، وبالتالي الحدّ من تقدمها.أوروبا المستندة إلى تاريخها الاستعماري والملتبس من دون مراجعة له، تحاول إعادة مدّ نفوذها إلى الشرق بدءًا من لبنان. أوروبا هذه التي تعاملها الولايات المتحدة بدونية واصفة إياها بالقارة العجوز، وبالإمبراطورية المريضة هي ما تسعى إلى تجديد سياساتها مع بلدان المشرق دون مراجعة، أو تقييم لماضي علاقاتها مع هذه الدول.هذه النماذج المنافسة والمتصارعة من دون هدف، تحاول أميركا عبرها ومنها صناعة الفوضى وحماية مصالحها، من دون الاكتراث لمصالح دول أخرى، سواء أكانت صغيرة أم كبيرة.تذكر صديقي سعد محيو، بل لنتذكر سويًّا بعض الأصدقاء المعنيين بالتجديد وإعادة المعنى للمشروع السياسي الاجتماعي الثقافي العربي، بخاصة في مصر الذين تعلمت منهم الكثير. فالمشروع الناصري في تاريخيته أصبح مرشدًا وقاعدة لكل التيارات السياسية في مصر والعالم العربي. نشير إلى ذلك ونحن نعلم أن المشروع الناصري كان عالميًّا، ومن أبرز من كانوا شركاء جمال عبد ناصر في ذاك الزمن الرؤساء شكري القوتلي ونهرو وتيتو وماو تسي تونغ وكاسترو وبن بيلا وبومدين، والحبيب بورقيبه وإن اختلفت وجهته عن الآخرين إلا أن مشروعه (العلماني) وبشكل خاص منه التربوي ونظرته لتحرير المرأة، يبقى نموذجًا متفردًا لا يمكن إلا الاعتراف بأنه كان على العرب أن يدرسوه، وينظروا إليه بعين الاعتبار، كذلك عبد السلام عارف وعبد الله السلال وفؤاد شهاب ولوممبا وغيرهم... هذا هو عالم عبد الناصر وهؤلاء هم بعض الشركاء من النخب المشاركة والشريكة في صناعة ذلك العالم وذاك الحلم الذي تحول بفضلهم إلى حقيقة في ذاك الوقت.حلم دول وشعوب عربية وافريقية وأسيوية شكلت حركات التحرر فيها الواجهة، وحملت قياداتها المشروع الذي كان واجهته المشروع المصري، مشروع عبد الناصر. فما كان يطمح له عبد الناصر هو أن يجعل من مصر والوطن العربي كتلة اجتماعية وعنوانًا للتغيير في مجرى التاريخ، محاولاً ومشاركًا في تأسيس الروافد والروافع العربية والافريقية والأسيوية التي تساهم في تحقيق المشروع المصري العربي.بدأ عبد الناصر في خلق محيطه العربي، فكانت باكورة ذلك الوحدة المصرية السورية التي تآمر عليها الكثيرون وفي مقدمتهم الأحزاب السورية، خاصة حزب البعث العربي الاشتراكي السوري الذى انسحبت كتلته برئاسة أكرم الحوراني من البرلمان، كذلك انسحب الحزب الشيوعي رافضًا الوحدة. ومن الطبيعي أن يكون الحزب القومي السوري التي كانت مواقفه واضحة بتحالفه مع قادة حلف بغداد، قد جمعته المصلحة مع الشيوعي والبعثي، ضد الوحدة. لقد تحولت تلك الأحزاب إلى أدوات بيد الخارج، وكانت مطية للأنظمه الرجعية في ذاك الوقت.إن ما يتجاهله من أرخوا لتلك المرحلة، خاصة من هذه الأحزاب، أن سوريا جديدة بُنيت خلال سنوات الوحدة، إذ تم مد شبكة الكهرباء إلى أنحاء القطر السوري، وبُنيت مئات المدارس والمستشفيات والجامعات، ووصل إلى الفلاحين كل ما يحتاجونه من أدوات صُنعت بأيدٍ مصرية سورية، كما شُقّت آلاف الكيلومترات من الطرق التي ربطت المحافظات السورية ببعضها البعض، كذلك مدت شبكات المياه إلى المنازل والمؤسسات، إلى غير ذلك من مشاريع. لقد بُنيت الأرضية الأساسية التي أدت إلى انتقال سوريا من عصر إلى عصر. لقد تقدمت سوريا عشرات السنين عمّا كانت عليه قبل الوحدة، كما كانت مصر عونًا للجزائر لتحريرها من الاستعمار الفرنسي، كذلك حُرر العراق واليمن وليبيا والسودان من الملكية والاستعمار والاقطاعية. بهذا يكون عبد الناصر ساهم في خلق محيطه العربي، وفي خلق المناخات للحوار والتعاون بين الدول والشعوب العربية والإفريقية وبين شعوب أميركا اللاتينية ودول أوروبا الشرقية التي لم تكن بعيدة من هذا الحلم المشروع، تلك الشعوب التي أصبحت كتلة متراصة غير منفصلة عن بعضها، بل أصبح كل منها سندًا للآخر، وخطًّا للدفاع عنه. وكانت الهند شريكة لعبد الناصر في عالمه، كذلك الصين التي لم تكن بعيدة، وإن كانت طموحات قياداتها الراديكلية أكثر غورًا وأبعد مدى. فمصر كانت المدرسة الأولى التي توارثت الصين تجربتها وقلدتها في تصنيع الحاجات البيتية. المشروع الناصري صنّع ما يحتاجه البيت المصري من حاجات، فلم يعد يحتاج إلى أي شيء من الخارج. كان ذلك قبل العام 1970م. لقد صُنّعت كل الحاجات البيتية بأيدٍ مصرية، وهذا ما فعلته الصين التي حولت هذا المشروع من محلي إلى عالمي، وها هي تغزو العالم بأجمعه بهذه الصناعات. أيضًا لم يكن من فواصل بين مصر ودول عدم الانحياز. مشروع عبد الناصر كان مشروع دول عدم الانحياز ذاته، مشروع التحرر السياسي والاجتماعي والثقافي من الاستعمار وعملائه. لقد كانت مصر، من ناحية التطور، تقارع اليابان، بل كانت في وضعية ندية معها متقدمة بذلك عن كوريا الجنوبية كما ذكر كل من سمير أمين وشارل بتلهايم. كذلك يوغسلافيا (تيتو) التي كانت على تعاون مع مصر في مجالات التصنيع العسكري، وكانت حليفة ناصر وشريكته في كل المجالات، وهو ناصر الذي استفاد من خبرات السلاف في التصنيع العسكري.كان الحضور السياسي لعبد الناصر قويًّا جدًا ليس في أميركا اللاتينية فحسب، بل في الولايات المتحدة الأميركية ذاتها مع المهاجرين العرب وغيرهم من المسحوقين ومن الهنود والاميركيين من أصول افريقية، إذ كانوا يعدّون أنفسهم جزءًا من مشروع تمثله مصر وكتلة عدم الانحياز. أصبح المشروع الناصري مشروع كل من يسعى إلى حرية الإنسان والعدالة الاجتماعية.إن الصورة التي رسمها عبد ناصر في مصر والعالم، كانت مثالًا، فقد بدأ في مصر بتحرير الأرض من الاقطاعيين، وبتحرير َمصر من الاستعمار، فالاستعمار والاقطاعيون كانوا حلفاء، وكانوا يتفننون في إذلال الفلاحين، وبالتالي الشعب المصري. لقد رسم ناصر صورة لمصر قائمة على تعزيز الانتماء للأرض وبالتالي للوطن، فكان الإصلاح الزراعي الذي ساهم في تعزيز الانتماء الوطني، قد استفاد منه الفلاحون وهم العنوان الأبرز للتحرر الاجتماعي الذي استكمله عبد الناصر ببناء السد، وبتوظيف الجامع والكنيسة والأزهر كمراكز تعليمية وإعلامية لخدمة مشروعه. لقد تحولت هذه من مؤسسات تخدم الاقطاع والاستعمار إلى مؤسسات للتغيير وتوجيه الرأي العام نحو التحرر. لم تعد هذه المؤسسات منفصلة عن العصر وعن هموم الناس.لقد جعل عبد الناصر من الجامع والكنيسة والأزهر مشاريعَ توجيهية وإعلامية لخدمة مشروعه، خاصة في مكافحة الأمية والتسول والبطالة، إذ منع التسول كما كافح الأمية، فعند وفاته كانت مصر شبه خالية من هذه الآفات، واستفاد من الإصلاح الزراعي ما يزيد على ثلاثة ملايين فلاح ومواطن مصري، أيضًا فتح أعين الأجيال الجديدة على العلوم والتقنيات الحديثة، ولم يكن من كتاب علمي يصدر عن أي مكان من العالم إلا وتكون دور النشر المصرية قد ترجمته ونشرته. بهذا التوجه كان يؤسس ناصر لعقلية علمية مصرية عربية مرتبطة بالعصر، فمن خلال توطين العلوم المعاصرة وجعلها مرجعية ومنهجًا في المدرسة والجامعة، تأسست مناخات مجتمعية مرتبطة بحاجات الإنسان، كما جعل من المنابر الإعلامية ودور النشر مؤسسات تعليمية وتنويرية َمتصلة بحاجات المجتمع، رابطًا إياها بالمدرسة والجامعة وبالتالي بمؤسسات المجتمع، تمامًا كما هي في الدول المتحضرة التي أصبحت فيها العلوم الحديثة مرشدة للعقول. لقد صنعت مصر الطائرة والثلاجة والسيارة بالتعاون مع الهند. وعبر هذه السياسة أصبحت التقنيات الحديثة بين أيدي المصريين، وأصبحت هذه التقنيات بين أيدي المواطن المصري مثله مثل أي مواطن من شعوب العالم المتقدم.عمم عبد الناصر المدارس والجامعات ومراكز الأبحاث، ومد الشبكات الكهربائية إلى كل أنحاء مصر، وأنشأ مئات المصانع والمدارس والجامعات، وحقق مجانية التعليم، كذلك عمم المستشفيات في كل المناطق، وحرر مصر من الاستعمار ومن الاقطاع، وفتح الطرق للمواطن المصري للتغيير، وتحققت أحلام المصريين التي كانت قبل العام 1952 كوابيس. كانت مهمة المدرسة والجامعة التأسيس لبناء مصر الجديدة أيضًا تزويد المؤسسات المصرية بالأطباء والمهندسين والاختصاصيين في مجالات العلوم المعاصرة كافة، ومنها المسرح والسينما والموسيقى وفن الرسم والإذاعة...كان عبد الناصر يضع نصب عينيه رسم صورة لأجيال جديدة وإدارة المؤسسات على تنوعها، وخلق الروافع العلمية البشرية والمادية الممتدة في النسيج المجتمعي المصري من دون توقف، ومن ضمن أهدافه أن يجعل من الريف مكانًا صالحًا للعيش ولسكن الأجيال. ومن مصر مرجعية علمية وبلدًا مكتفيًا ذاتيًّا. لقد أصبحت الصناعات المصرية ماركات عالمية. وعلى الرغم من نكسة العام 1967م، إلا أن مصر أصبحت مرجعًا عالميًّا وقبلة للعلماء، واقتربت من أن تصبح بلدًا مكتفيًا ذاتيًّا.لكن وللأسف، نرى اليوم أن الإعلام والمنظرين على شاشاته، يحاولون تشويه هذا التاريخ الذي صنعته العقول المصرية العربية، وحولته الأيدي والعقول في المصانع والجامعات والمدارس وعلى امتداد الأرض المصرية والعربية إلى واقع. (لقد جاء السادات فحوّل الحلم إلى كوابيس، وعادت مصر في عهده إلى سابق ما كانت عليه قبل العام 1952م وهذا بحاجة إلى دراسة أخرى منفصلة عما نؤرخ له ونشير إليه). لقد تجاهل الإعلام خلال عهدي السادات ومبارك هذه الانجازات، يتجاهل ما حققته العقول المصرية العربية من إنجازات حققها الشعب المصري العربي، الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، وبايعاز من السلطة الحاكمة كانت مهمته تشويه صورة ما كانت عليه مصر في ذلك الزمن.إن ما يقوم به الإعلام غريب ومريب أيضًا؛ يشوّه هذا التاريخ ليجعل الشعب المصري في حالة ضياع، والحجة عدم وجود ديمقراطية في مصر، في حين ان المشروع الناصري كان يخدم ويمثل 90 في المئة من مصالح المصريين. وإن كنا نتساءل عن أية ديمقراطية يتحدثون، فهل كانت أوضاع الشعب الصيني (خاصة لجهة حقوق الإنسان) الاجتماعية والثقافية أفضل مما كانت عليه في َمصر، أو أوضاع الاتحاد السوفياتي أو حتى أوضاع الولايات المتحده الأميركية ذاتها التي منعت نشر كتب هنري ملير، ومنعت توزيع الكتب الشيوعية، كذلك كانت تلاحق الشيوعيين، ولم تسمح في تأسيس أحزاب شيوعية أو... أفضل حالا مما كانت تعرفه مصر؟اليوم أميرکا تزوّر كل شيء، هي من ترسم صورة العالم على قياس مصالحها. ويساهم النظام الرأسمالي في خلق عالم موزييك مشوّه. أميركا تستخدم الطوائف لتنفيذ مشروعها الهادف لبقاء العالم العربي على ما هو عليه من تخلف، وبالتالي لصناعة جبهات وأحلاف طائفية من باكستان إلى أفغانستان إلى السعودية فتركيا. هذه الدول التي يحاول أن يجعل منها وبينها حلفًا سنيًّا في مواجهة ما تم تسميته بحلف "الهلال الشيعي" الذي تتزعمه إیران وتحاول الولايات المتحدة تثبيته، على أن تكون إسرائيل بين هذا وذاك الحكم.لقد رسمت الولايات المتحدة صورة لما تريد أن يعزز سيطرتها، فكانت الأيديولوجيات الدينية التي تمت صناعتها وتجديد مهمتها أمريكيًّا، أن تحولت إلى مشاريع لتفتيت المنطقة، وإلى دويلات يمكن اللعب بها، وجعلها أدوات طيّعة لخدمة مشاريعها، فضلاً عن تغليب الفكر الديني القبلي على الفكر الوطني والقومي.وهنا نلفت النظر إلى نماذج أخرى موجودة وجاهزة للاستعمال، والسؤال عن مهمتها: ما هي مهمة الحرکة الصهيونية، أيضا الحركة الوهابية، أيضا حركة ولاية الفقيه، وأخيرًا الحركة المهزومة حركة الاخوان المسلمين؟ هذه الحركات القبلية التي تستغلها الولايات المتحدة الأميركية وتسعى إلى تحريكها في الوقت المناسب، غب الطلب، ومتی تشاء لحروب أهلية قد تدوم لمئات السنين. إن هذه الحركات التي تسيّرها الولايات المتحدة هي مشاريع مستقبلية، وستكون مصر والجزائر والسودان والسعودية بعضًا من الساحات المقبلة، وهناك أمثلة من الدول التي يعمل بها النظام الرأسمالي ولم يكتمل مشروعه فيها، تتبدى في الصور التي رسمتها لليبيا واليمن والعراق وسوريا والسودان ولبنان، حيث تهدف أميركا إلى تجزئة هذه البلدان وتقسيمها، ومحاولة إعادتنا إلى العصور القبلية. هذا هو هدف الولايات المتحدة الأميركية، وهذا ما ترغب به وتعمل على تنفيذه، وهو ما على شعوب المنطقه الانتباه منه، كما علينا ألا ننسی القواعد الأميركية المنتشرة في غير مكان من العالم، وبخاصة العالم العربي منه، حيث هذه القواعد موجودة لكبح وضرب أي تقدم أو تطور.
*** مجلة الحداثة - ربيع 2021 - عدد 215 /216 - Al Hadatha Journal
Published on July 21, 2021 09:07
نوافذ: تجربة الاكتفاء الذاتي الناصرية مرجعية لمواجهة التغريب (حوار مع صديقي سعد محيو)
 ♦ فرحان صالح
♦ فرحان صالحيتغير العالم، يتبدل، هناك فوضى عالمية بدأت قبل عهد ترامب، لكنها مستمرة، ومن علامات ذلك أن الامبراطوريات الجديدة المناهضة للولايات المتحدة لم تثبت أقدامها في أي موقع وصلت إليه؛ هذه روسيا في سوريا، الوحود الملتبس والمشروع المبهم، وهذه الولايات المتحدة الأميركية ذاتها تنسحب وتتراجع مهزومة من أفغانستان، وهي تسعى إلى تعزيز حضور القبليات الدينية والعنصرية في أي مكان تحلّ به، بدءًا من أفغانستان، وتستعمل المحيط البشري الإسلامي بشقيه السني والشيعي المحيط بروسيا، والمنسحب من نسيج المجتمعات الإسلامية، قاعدة خدمات لها ولأدواتها، فالقوات الأميركية وهي تنسحب من أفغانستان، تخطط كي تجعل من طالبان أداة متعددة الأهداف، ليس ضد روسيا فحسب، بل لإيجاد توترات مستمرة مع باكستان وايران وصولا للهند أيضًا، ولن تكون الدول الإسلامية المحيطة بروسيا بعيدة من مرماها. وإن كان الهدف الأساسي للولايات المتحدة حصار روسيا ومنعها من التمدد... أيضًا لمنع أية حركة تغييرية في الوطن العربي.ليست النهاية هنا، بل تحاول الولايات المتحدة الأميركية تعزيز أمراضها حول العالم ظنًا منها أنها بذلك تحمي نفسها ومصالحها. تحاول أمريكا محاصرة الصين، وهي دون تاريخ استعماري تستند إليه، من خلال اتفاقات تعاون تجربها أميركا مع الدول المحيطة بالصين، والهدف منع تمدد الصين، وبالتالي الحدّ من تقدمها.أوروبا المستندة إلى تاريخها الاستعماري والملتبس من دون مراجعة له، تحاول إعادة مدّ نفوذها إلى الشرق بدءًا من لبنان. أوروبا هذه التي تعاملها الولايات المتحدة بدونية واصفة إياها بالقارة العجوز، وبالإمبراطورية المريضة هي ما تسعى إلى تجديد سياساتها مع بلدان المشرق دون مراجعة، أو تقييم لماضي علاقاتها مع هذه الدول.هذه النماذج المنافسة والمتصارعة من دون هدف، تحاول أميركا عبرها ومنها صناعة الفوضى وحماية مصالحها، من دون الاكتراث لمصالح دول أخرى، سواء أكانت صغيرة أم كبيرة.تذكر صديقي سعد محيو، بل لنتذكر سويًّا بعض الأصدقاء المعنيين بالتجديد وإعادة المعنى للمشروع السياسي الاجتماعي الثقافي العربي، بخاصة في مصر الذين تعلمت منهم الكثير. فالمشروع الناصري في تاريخيته أصبح مرشدًا وقاعدة لكل التيارات السياسية في مصر والعالم العربي. نشير إلى ذلك ونحن نعلم أن المشروع الناصري كان عالميًّا، ومن أبرز من كانوا شركاء جمال عبد ناصر في ذاك الزمن الرؤساء شكري القوتلي ونهرو وتيتو وماو تسي تونغ وكاسترو وبن بيلا وبومدين، والحبيب بورقيبه وإن اختلفت وجهته عن الآخرين إلا أن مشروعه (العلماني) وبشكل خاص منه التربوي ونظرته لتحرير المرأة، يبقى نموذجًا متفردًا لا يمكن إلا الاعتراف بأنه كان على العرب أن يدرسوه، وينظروا إليه بعين الاعتبار، كذلك عبد السلام عارف وعبد الله السلال وفؤاد شهاب ولوممبا وغيرهم... هذا هو عالم عبد الناصر وهؤلاء هم بعض الشركاء من النخب المشاركة والشريكة في صناعة ذلك العالم وذاك الحلم الذي تحول بفضلهم إلى حقيقة في ذاك الوقت.حلم دول وشعوب عربية وافريقية وأسيوية شكلت حركات التحرر فيها الواجهة، وحملت قياداتها المشروع الذي كان واجهته المشروع المصري، مشروع عبد الناصر. فما كان يطمح له عبد الناصر هو أن يجعل من مصر والوطن العربي كتلة اجتماعية وعنوانًا للتغيير في مجرى التاريخ، محاولاً ومشاركًا في تأسيس الروافد والروافع العربية والافريقية والأسيوية التي تساهم في تحقيق المشروع المصري العربي.بدأ عبد الناصر في خلق محيطه العربي، فكانت باكورة ذلك الوحدة المصرية السورية التي تآمر عليها الكثيرون وفي مقدمتهم الأحزاب السورية، خاصة حزب البعث العربي الاشتراكي السوري الذى انسحبت كتلته برئاسة أكرم الحوراني من البرلمان، كذلك انسحب الحزب الشيوعي رافضًا الوحدة. ومن الطبيعي أن يكون الحزب القومي السوري التي كانت مواقفه واضحة بتحالفه مع قادة حلف بغداد، قد جمعته المصلحة مع الشيوعي والبعثي، ضد الوحدة. لقد تحولت تلك الأحزاب إلى أدوات بيد الخارج، وكانت مطية للأنظمه الرجعية في ذاك الوقت.إن ما يتجاهله من أرخوا لتلك المرحلة، خاصة من هذه الأحزاب، أن سوريا جديدة بُنيت خلال سنوات الوحدة، إذ تم مد شبكة الكهرباء إلى أنحاء القطر السوري، وبُنيت مئات المدارس والمستشفيات والجامعات، ووصل إلى الفلاحين كل ما يحتاجونه من أدوات صُنعت بأيدٍ مصرية سورية، كما شُقّت آلاف الكيلومترات من الطرق التي ربطت المحافظات السورية ببعضها البعض، كذلك مدت شبكات المياه إلى المنازل والمؤسسات، إلى غير ذلك من مشاريع. لقد بُنيت الأرضية الأساسية التي أدت إلى انتقال سوريا من عصر إلى عصر. لقد تقدمت سوريا عشرات السنين عمّا كانت عليه قبل الوحدة، كما كانت مصر عونًا للجزائر لتحريرها من الاستعمار الفرنسي، كذلك حُرر العراق واليمن وليبيا والسودان من الملكية والاستعمار والاقطاعية. بهذا يكون عبد الناصر ساهم في خلق محيطه العربي، وفي خلق المناخات للحوار والتعاون بين الدول والشعوب العربية والإفريقية وبين شعوب أميركا اللاتينية ودول أوروبا الشرقية التي لم تكن بعيدة من هذا الحلم المشروع، تلك الشعوب التي أصبحت كتلة متراصة غير منفصلة عن بعضها، بل أصبح كل منها سندًا للآخر، وخطًّا للدفاع عنه. وكانت الهند شريكة لعبد الناصر في عالمه، كذلك الصين التي لم تكن بعيدة، وإن كانت طموحات قياداتها الراديكلية أكثر غورًا وأبعد مدى. فمصر كانت المدرسة الأولى التي توارثت الصين تجربتها وقلدتها في تصنيع الحاجات البيتية. المشروع الناصري صنّع ما يحتاجه البيت المصري من حاجات، فلم يعد يحتاج إلى أي شيء من الخارج. كان ذلك قبل العام 1970م. لقد صُنّعت كل الحاجات البيتية بأيدٍ مصرية، وهذا ما فعلته الصين التي حولت هذا المشروع من محلي إلى عالمي، وها هي تغزو العالم بأجمعه بهذه الصناعات. أيضًا لم يكن من فواصل بين مصر ودول عدم الانحياز. مشروع عبد الناصر كان مشروع دول عدم الانحياز ذاته، مشروع التحرر السياسي والاجتماعي والثقافي من الاستعمار وعملائه. لقد كانت مصر، من ناحية التطور، تقارع اليابان، بل كانت في وضعية ندية معها متقدمة بذلك عن كوريا الجنوبية كما ذكر كل من سمير أمين وشارل بتلهايم. كذلك يوغسلافيا (تيتو) التي كانت على تعاون مع مصر في مجالات التصنيع العسكري، وكانت حليفة ناصر وشريكته في كل المجالات، وهو ناصر الذي استفاد من خبرات السلاف في التصنيع العسكري.كان الحضور السياسي لعبد الناصر قويًّا جدًا ليس في أميركا اللاتينية فحسب، بل في الولايات المتحدة الأميركية ذاتها مع المهاجرين العرب وغيرهم من المسحوقين ومن الهنود والاميركيين من أصول افريقية، إذ كانوا يعدّون أنفسهم جزءًا من مشروع تمثله مصر وكتلة عدم الانحياز. أصبح المشروع الناصري مشروع كل من يسعى إلى حرية الإنسان والعدالة الاجتماعية.إن الصورة التي رسمها عبد ناصر في مصر والعالم، كانت مثالًا، فقد بدأ في مصر بتحرير الأرض من الاقطاعيين، وبتحرير َمصر من الاستعمار، فالاستعمار والاقطاعيون كانوا حلفاء، وكانوا يتفننون في إذلال الفلاحين، وبالتالي الشعب المصري. لقد رسم ناصر صورة لمصر قائمة على تعزيز الانتماء للأرض وبالتالي للوطن، فكان الإصلاح الزراعي الذي ساهم في تعزيز الانتماء الوطني، قد استفاد منه الفلاحون وهم العنوان الأبرز للتحرر الاجتماعي الذي استكمله عبد الناصر ببناء السد، وبتوظيف الجامع والكنيسة والأزهر كمراكز تعليمية وإعلامية لخدمة مشروعه. لقد تحولت هذه من مؤسسات تخدم الاقطاع والاستعمار إلى مؤسسات للتغيير وتوجيه الرأي العام نحو التحرر. لم تعد هذه المؤسسات منفصلة عن العصر وعن هموم الناس.لقد جعل عبد الناصر من الجامع والكنيسة والأزهر مشاريعَ توجيهية وإعلامية لخدمة مشروعه، خاصة في مكافحة الأمية والتسول والبطالة، إذ منع التسول كما كافح الأمية، فعند وفاته كانت مصر شبه خالية من هذه الآفات، واستفاد من الإصلاح الزراعي ما يزيد على ثلاثة ملايين فلاح ومواطن مصري، أيضًا فتح أعين الأجيال الجديدة على العلوم والتقنيات الحديثة، ولم يكن من كتاب علمي يصدر عن أي مكان من العالم إلا وتكون دور النشر المصرية قد ترجمته ونشرته. بهذا التوجه كان يؤسس ناصر لعقلية علمية مصرية عربية مرتبطة بالعصر، فمن خلال توطين العلوم المعاصرة وجعلها مرجعية ومنهجًا في المدرسة والجامعة، تأسست مناخات مجتمعية مرتبطة بحاجات الإنسان، كما جعل من المنابر الإعلامية ودور النشر مؤسسات تعليمية وتنويرية َمتصلة بحاجات المجتمع، رابطًا إياها بالمدرسة والجامعة وبالتالي بمؤسسات المجتمع، تمامًا كما هي في الدول المتحضرة التي أصبحت فيها العلوم الحديثة مرشدة للعقول. لقد صنعت مصر الطائرة والثلاجة والسيارة بالتعاون مع الهند. وعبر هذه السياسة أصبحت التقنيات الحديثة بين أيدي المصريين، وأصبحت هذه التقنيات بين أيدي المواطن المصري مثله مثل أي مواطن من شعوب العالم المتقدم.عمم عبد الناصر المدارس والجامعات ومراكز الأبحاث، ومد الشبكات الكهربائية إلى كل أنحاء مصر، وأنشأ مئات المصانع والمدارس والجامعات، وحقق مجانية التعليم، كذلك عمم المستشفيات في كل المناطق، وحرر مصر من الاستعمار ومن الاقطاع، وفتح الطرق للمواطن المصري للتغيير، وتحققت أحلام المصريين التي كانت قبل العام 1952 كوابيس. كانت مهمة المدرسة والجامعة التأسيس لبناء مصر الجديدة أيضًا تزويد المؤسسات المصرية بالأطباء والمهندسين والاختصاصيين في مجالات العلوم المعاصرة كافة، ومنها المسرح والسينما والموسيقى وفن الرسم والإذاعة...كان عبد الناصر يضع نصب عينيه رسم صورة لأجيال جديدة وإدارة المؤسسات على تنوعها، وخلق الروافع العلمية البشرية والمادية الممتدة في النسيج المجتمعي المصري من دون توقف، ومن ضمن أهدافه أن يجعل من الريف مكانًا صالحًا للعيش ولسكن الأجيال. ومن مصر مرجعية علمية وبلدًا مكتفيًا ذاتيًّا. لقد أصبحت الصناعات المصرية ماركات عالمية. وعلى الرغم من نكسة العام 1967م، إلا أن مصر أصبحت مرجعًا عالميًّا وقبلة للعلماء، واقتربت من أن تصبح بلدًا مكتفيًا ذاتيًّا.لكن وللأسف، نرى اليوم أن الإعلام والمنظرين على شاشاته، يحاولون تشويه هذا التاريخ الذي صنعته العقول المصرية العربية، وحولته الأيدي والعقول في المصانع والجامعات والمدارس وعلى امتداد الأرض المصرية والعربية إلى واقع. (لقد جاء السادات فحوّل الحلم إلى كوابيس، وعادت مصر في عهده إلى سابق ما كانت عليه قبل العام 1952م وهذا بحاجة إلى دراسة أخرى منفصلة عما نؤرخ له ونشير إليه). لقد تجاهل الإعلام خلال عهدي السادات ومبارك هذه الانجازات، يتجاهل ما حققته العقول المصرية العربية من إنجازات حققها الشعب المصري العربي، الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، وبايعاز من السلطة الحاكمة كانت مهمته تشويه صورة ما كانت عليه مصر في ذلك الزمن.إن ما يقوم به الإعلام غريب ومريب أيضًا؛ يشوّه هذا التاريخ ليجعل الشعب المصري في حالة ضياع، والحجة عدم وجود ديمقراطية في مصر، في حين ان المشروع الناصري كان يخدم ويمثل 90 في المئة من مصالح المصريين. وإن كنا نتساءل عن أية ديمقراطية يتحدثون، فهل كانت أوضاع الشعب الصيني (خاصة لجهة حقوق الإنسان) الاجتماعية والثقافية أفضل مما كانت عليه في َمصر، أو أوضاع الاتحاد السوفياتي أو حتى أوضاع الولايات المتحده الأميركية ذاتها التي منعت نشر كتب هنري ملير، ومنعت توزيع الكتب الشيوعية، كذلك كانت تلاحق الشيوعيين، ولم تسمح في تأسيس أحزاب شيوعية أو... أفضل حالا مما كانت تعرفه مصر؟اليوم أميرکا تزوّر كل شيء، هي من ترسم صورة العالم على قياس مصالحها. ويساهم النظام الرأسمالي في خلق عالم موزييك مشوّه. أميركا تستخدم الطوائف لتنفيذ مشروعها الهادف لبقاء العالم العربي على ما هو عليه من تخلف، وبالتالي لصناعة جبهات وأحلاف طائفية من باكستان إلى أفغانستان إلى السعودية فتركيا. هذه الدول التي يحاول أن يجعل منها وبينها حلفًا سنيًّا في مواجهة ما تم تسميته بحلف "الهلال الشيعي" الذي تتزعمه إیران وتحاول الولايات المتحدة تثبيته، على أن تكون إسرائيل بين هذا وذاك الحكم.لقد رسمت الولايات المتحدة صورة لما تريد أن يعزز سيطرتها، فكانت الأيديولوجيات الدينية التي تمت صناعتها وتجديد مهمتها أمريكيًّا، أن تحولت إلى مشاريع لتفتيت المنطقة، وإلى دويلات يمكن اللعب بها، وجعلها أدوات طيّعة لخدمة مشاريعها، فضلاً عن تغليب الفكر الديني القبلي على الفكر الوطني والقومي.وهنا نلفت النظر إلى نماذج أخرى موجودة وجاهزة للاستعمال، والسؤال عن مهمتها: ما هي مهمة الحرکة الصهيونية، أيضا الحركة الوهابية، أيضا حركة ولاية الفقيه، وأخيرًا الحركة المهزومة حركة الاخوان المسلمين؟ هذه الحركات القبلية التي تستغلها الولايات المتحدة الأميركية وتسعى إلى تحريكها في الوقت المناسب، غب الطلب، ومتی تشاء لحروب أهلية قد تدوم لمئات السنين. إن هذه الحركات التي تسيّرها الولايات المتحدة هي مشاريع مستقبلية، وستكون مصر والجزائر والسودان والسعودية بعضًا من الساحات المقبلة، وهناك أمثلة من الدول التي يعمل بها النظام الرأسمالي ولم يكتمل مشروعه فيها، تتبدى في الصور التي رسمتها لليبيا واليمن والعراق وسوريا والسودان ولبنان، حيث تهدف أميركا إلى تجزئة هذه البلدان وتقسيمها، ومحاولة إعادتنا إلى العصور القبلية. هذا هو هدف الولايات المتحدة الأميركية، وهذا ما ترغب به وتعمل على تنفيذه، وهو ما على شعوب المنطقه الانتباه منه، كما علينا ألا ننسی القواعد الأميركية المنتشرة في غير مكان من العالم، وبخاصة العالم العربي منه، حيث هذه القواعد موجودة لكبح وضرب أي تقدم أو تطور.
*** مجلة الحداثة - ربيع 2021 - عدد 215 /216 - Al Hadatha Journal
Published on July 21, 2021 09:07
•
Tags:
مجلة_الحداثة
July 15, 2021
الافتتاحية: نداء إلى مسرحيي العالم: اهدموا "الجدار الخامس"


♦ هشام شامل زين الدين *
أحدثت تداعيات فايروس كورونا على الفنون عمومًا والمسرح خصوصًا تحولًا دراماتيكيًا في أسلوب التواصل بين المسرحي وجمهوره، وانعكس ذلك على مفهوم الفن المسرحي ودوره ووظيفته وطرائق عرضه وتلقيه، مما أوقع العديد من المسرحيين في حيرة من أمرهم: هل يستسلمون للتغيير المفروض عليهم بقوة الفيروس أم ينتظرون إلى حين زواله ويعودون إلى خشباتهم وجمهورهم؟انطلقت فكرة وجود "الجدار الخامس" في المسرح من الأزمة المستجدة والضياع الذي أحدثته بيننا كمسرحيين، هذا الجدار الذي فُرض علينا وبات حاضرًا في يومياتنا وفي أنشطتنا المسرحية "الالكترونية" كافة.فلماذا تسميته بـ"الجدار الخامس"؟منذ منتصف القرن العشرين بدأت جهود المنظرين والعاملين في المسرح العالمي وخصوصًا الأوروبي، لتحطيم "الجدار الرابع" الذي يفصل بين خشبة المسرح وصالة الجمهور والذي كان يمنع حدوث التفاعل الفكري بين العرض والمتلقي، لأن المسرح التقليدي قام خلال قرون طويلة، على مبدأ الايهام المسرحي.إن طرح فكرة وجود "الجدار الخامس" في المسرح اليوم، تستوجب التوقف عندها، وبدء التفكير بكيفية هدمه والتخلص منه تمامًا، كما أفرزت التجارب الحداثية والطليعية في مسرح القرن العشرين أفكارًا وممارسات عملية أدت إلى هدم الجدار الرابع والخروج من زمن الكلاسيكية والتقليد إلى زمن التجديد والحداثة في المسرح العالمي على أيدي الروسي ميير خولد (Vsevolod Meyerhold/ 1874– 1940)، والألماني بريخت (Brecht/ 1898– 1956) والبولندي غروتوفسكي (Grotowski/ 1933– 1999) والكثيرين غيرهم.إن مصطلح "الجدار الخامس" (التكنولوجي) في المسرح جديد، ولا يوجد توصيف نظري له بعد، وهو يتمحور حول مسألة التحدي الذي سنواجهه في المستقبل والمتعلق بضرورة هدم هذا الجدار في المسرح، الجدار الإلكتروني الذي هبط على المسرحيين كالقدر، وهو يمثل اليوم مشكلة وجودية على الرغم من محاولات بعض المسرحيين التكيف معه كواقع مفروض علينا نتيجة لتفشي وباء كورونا.إن "الجدار الخامس" المتمثل بالأجهزة الالكترونية وشاشاتها الزجاجية الذكية (الكمبيوتر، اللابتوب، التلفون، الالواح الالكترونية...) التي نشاهد من خلالها المسرح الافتراضي، هو أخطر على عملية التلقي وعلى جماليات العرض المسرحي وعلى جدلية التأثر والتأثير الفكري والحسي في المسرح من الجدار الرابع الوهمي الذي كان يفصل بين المشاهد والممثل على الخشبة في القرون الماضية.إن هذا الجدار الجديد أشد خطورة، لأنه يقضي على مبرر وجود المسرح في الحياة، أي الشعور الحي التفاعلي بين كائنات حية تجهد جماليًا وفكريًا وجسديًا من أجل تبادل شيفرات وعلامات وحركات وأصوات وكلمات وأحاسيس إنسانية بالدرجة الأولى كانت موجودة قبل التكنولوجيا وستبقى بعدها.إن الرضوخ والقبول بوجود الجدار الخامس هو بمثابة اطلاق رصاصة الرحمة على المسرح الحي، وكما كسّر طليعيو المسرح في القرن العشرين الجدار الرابع وهدّموه، علينا أن نتصدى بكل امكاناتنا الفكرية والجمالية والجسدية والنضالية حتى، كي نمنع هذا الجدار من الترسخ والتشبت بخشبة المسرح كجزء أساسي منها في المستقبل.أطلق هذه العبارة أو هذا المصطلح "الجدار الخامس" في المسرح للتنبيه من خطورته، وأنا لا أملك أجوبة عن تساؤلاتي حوله، ولا أعرف إذا كنا في السنوات المقبلة سنتمكن من الانتصار للمسرح الإنساني الحي الشفاف الصادق العفوي، والابقاء عليه من دون أي حواجز إلكترونية وغيرها، ولا أستطيع التكهن بمفاجآت التطور التكنولوجي، هذا "الوحش الجميل" الذي يجتاحنا بذكائه الاصطناعي بسرعة هائلة، وأدعو عبر افتتاحية "مجلة الحداثة اللبنانية" مجددًا،** كل المسرحيين في لبنان والعالم، إلى هذه المقاومة، وسلاحنا في هذه المعركة بسيط جدًا؛ الخشبة والصالة والجمهور، ورفض عرض الأعمال المسرحية على الشاشات الإلكترونية، ورفض تحويلها الى فن آخر يستمد حضوره من الكاميرا والشاشة والكهرباء، لأن ذلك سيشكل بداية مرحلة الانقراض للفن المسرحي آخر الفنون الحيّة التي لا تزال تعتمد بشكل أساس على النبض الإنساني والشعور والتفاعل الحي.**** بروفيسور في الجامعة اللبنانية (رئيس الفرقة البحثية في الفنون البصرية). باحث ومؤلف ومخرج مسرحي** كنت قد طرحت مصطلح "الجدار الخامس في المسرح" في بحث لي قدمته في ندوة افتراضية بمناسبة اليوم العالمي للمسرح ضمن فعالية لـ"ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي" – آذار (مارس) 2021
Published on July 15, 2021 12:47
•
Tags:
مجلة_الحداثة
سنة ترامب الأخيرة في الحكم عبر ثلاث صور - تحليل سيميائي لنماذج من "أرض اليوتوبيا والأحلام"

♦ حوراء موسى حوماني *
- نبذة عن البحث:
طبعت السنة الأخيرة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب (Donald Trump) في الإدارة الأميركية أحداثًا عدة على المستويات السياسية والأمنية والصحية التي أثّرت في صورة الأمة الأميركية. هذه الصورة التي كانت حتى وقت ما قبل التقاط الصور ورواجها مثالًا عن الديمقراطية وحرية الرأي والقوة العسكرية والأمنية، كذلك في القدرات الصحية. فقد واجه القطاع الطبي في أميركا مجموعة تحديات مع انتشار فايروس كورونا (COVID-19) تمثلت إحداها في نقص في التجهيزات الطبية مثل اللباس الواقي من انتقال العدوى والخاص بأفراد القطاع الطبي، فبرزت صورة ممرضات في إحدى المستشفيات الأميركية ترتدين أكياس النايلون لتحمين أنفسهن من الفايروس أثناء أدائهن لوظائفهن. كذلك شكلت حادثة قتل المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد (George Floyd) انقلابًا في الشارع الأميركي أعاد إحياء النقمة السوداء تجاه عنصرية الرجل الأبيض في "أرض اليوتوبيا والأحلام".كما صدمت صورة ترامب الرافض للنتائج الديمقراطية لانتخابات الرئاسية الأخيرة ودوره في حادثة اقتحام الكابتول. فدارت أسئلة عديدة في أذهان المراقبين والمشاهدين إزاء هذه الصور وأحداثها وما فرضته على "جمهورية التسلية"، كما يرى الكاتب والناقد السينمائي الأميركي نيال غابلر (Neal Gabler) أميركا. فتساءلوا جميعًا: هل هذه الصور حقيقة؟ وهل هذه هي إمبراطورية "الحلم" الأميركية التي كانوا يشاهدونها مدهوشين بقدراتها في أفلام هوليوود؟فكيف تغيرت صورة أميركا على المستوى السياسي والأمني والصحي ضمن تحليل سيميائي للصور الأكثر شهرة خلال العام الأخير من حكم ترامب؟**** باحثة لبنانية - دكتورة في علوم الإعلام والاتصال
Published on July 15, 2021 12:39
من الميتولوجيا إلى المسرح معاناة الوجود البشريّ

♦ جان إلياس القسّيس *
- نبذة عن البحث:
كثيرةٌ هي الدراسات الَّتي تناولت نشأَة المسرح عند الإِغريق قبل حوالى أَلْفَيْن وخمسمئة عام. هذا التاريخ هو في الواقع يشهد على ولادة "المسرحيَّة"، أَمَّا "المسرح" فقد عرفته البشريَّة منذ أَن كانت. وبهذا نفرّق ما بين "المسرح" و"المسرحيَّة"؛ "فالمسرح" شكلٌ إحتفاليٌّ ابتدأَ مع أَنشطة الصيد الأَولى الَّتي عرفها الإِنسان البَدَئيُّ، لتشمل كلَّ احتفاليَّات السحر والخصب والموت... أَمَّا "المسرحيَّة" فهي شكلٌ أَدبيٌّ، انطلق من تلك الاحتفاليّات نفسها، لينتظم لاحقًا في إطارٍ محدَّدٍ بموضوعٍ معينٍ وزمانٍ ومكان.والمسرح الإِغريقيُّ الَّذي اعتمده الدارسون والباحثون نقطة البَدءِ بالنسبة إلى المسرح العالميِّ، نشأ أصلاً كعملٍ دينيٍّ يعالج موضوعاتٍ مستمدّة من صُلب العبادة ومن عالم الآلهة "الَّذي أَوجَدَه اليونانيّون بحُكم الضرورةِ القصوى، ليتمكَّنوا من تحمُّل تَبِعات الوجود"،1 وذلك عبْر الأَساطير، وعبر التعامل والتفاعل مع الأَسرار الغيبيَّة في عالمٍ مطلقٍ تشوبه الفوضى ويعتريه الغموض وتتحكَّم فيه الحتميَّة القدريَّة. وعليه، فإنَّ القول بعلاقةٍ ما بين المسرح والميتولوجيا، يبقى مبهمًا ما لم نخُضْ في مظاهر تلك الميتولوجيا وتفاصيلها، لإماطة اللِّثام عن خفاياها ورموزها الَّتي تناولتها موضوعات المسرحيَّات الأُولى، وانطلقت منها إِلى كشف حقيقة ما يؤمن به الإِنسان المذعن لمشيئةٍ قدريَّةٍ لا يجد منها خلاصًا. فأَتى المسرح ليفتح له بابًا إِلى المعرفة أَوَّلاً، ثمّ إِلى التمرُّد والتخطّي.تبرز أمامنا هنا إِشكاليةٌ في كيفية مفهوم التخطّي الَّذي يمكن تفسيره بتجاوز الأَعراف الإِلهيَّة، وإِدارة الوجه عن أشكال العبادة الَّتي ارتضاها الإنسان منذ أَن وُجد، وربط بها مسار حياته كلِّها، واستسلم لمشيئة أربابه، أيَّا تكن هذه الأَرباب، وتركها تتحكَّم في قدره ومصيره، في غياب الوعي الَّذي يحدِّد وحده صوابية الولاءِ والانتماء. فهل جاء المسرح ليوقظ هذا الوعي الخامد، ويدفع بالإِنسان لا إِلى تخطّي قَدَره فحسب، بل إِلى تخطّي ذاته أَوَّلاً وإِدراك حقيقة وجوده؟**** يعدّ أطروحة دكتوراه في الفنّ وعلوم الفنّ (اختصاص مسرح) – المعهد العالي للدكتوراه – الجامعة اللبنانية
Published on July 15, 2021 12:32
Role of the Media and Social Networking in improving the situation of the Syrian Refugees in Lebanon
♦ Loubane Mohammed Tay *
- نبذة عن البحث :
دور وسائل الإعلام الاجتماعية وشبكاتها في تحسين أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان
إنّ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي الجهة المسؤولة عن النازحين السوريين في لبنان، تسجّلهم تحت مسمّى "اللاجئين السوريين"، وتعمل على حمايتهم وتأمين احتياجاتهم، وهو ما حقّقته مستعينةً بمعلومات جُمعت على شبكات الإعلام الاجتماعية صُمّمت لهذه الغاية. فلقد تمكنت المفوضيّة من خلق شبكات تواصل اجتماعي تصل إلى غالبية النازحين، وتسمح بالتواصل وتبادل المعلومات معهم، وبنشر دراسات وتقارير حول وضعهم، والتنسيق مع السلطات اللبنانية المحلية ومؤسسات المجتمع المدني المحليّة والدوليّة لتلبيت اجتياجاتهم.وهنا نسأل: كيف يمكن استخدام هذه الوسائل لتنظيم شؤون اللاجئين السوريين في لبنان وتحسين أوضاعهم، بالرغم من ظروفهم الدقيقة من ناحية الحفاظ على خصوصيّة البيانات المرتبطة بالنازحين، ومن صعوبة وضعهم الأمني، والاجتماعي، والاقتصادي والصحي؟الكلمات المفتاحيّة: شبكات ووسائل الإعلام الاجتماعية - النازحين / اللاجئين السوريين – تنظيم داتا معلومات - تواصل وتبادل المعلومات - خصوصية البيانات.***For years, Lebanon has remained the country hosting the largest number of refugees per capita. According to a 2021 UNHCR report, the country has about 891,300 registered refugees with 97.1% of them originating from Syria and the others of Palestinian, Iraqi, Sudanese and other origins (1), in 2020, the total number of refugees in Lebanon was estimated to be more than a million and a half, an equivalent of about one third of the country’s total population.The massive influx of Syrian refugees ever since 2011 into the country has been exerting considerable pressure on different sectors such as security, labour market, health, and education services. The refugee crisis is further complicated by the age-groups and gender diversity as well as the different vulnerabilities that create networking and communication challenges among the refugee population and with their host communities.Given the situation, the Lebanese government instructed the UNHCR to suspend the registration of refugees at the beginning of 2015. This singular decision has been creating such information gap on the real number of persons fleeing from war zones, and leaving unregistered children, women, elderly persons, and persons living with disabilities, exposed to further vulnerabilities. Current events have been hitting hard, thereby making the refugee crisis in Lebanon a protracted one. The country registered a full-blown economic crisis. Years of decelerated growth meant a halt on subsidization in the social domain, reduced investment in infrastructural development. This resulted in further neglect on the needs of refugees.(2)The protracted nature of the situation in Lebanon and with limited self reliance possibilities are having serious tolls on refugee. The use of social media and social networking has become a veritable force in fighting poverty and building communities through communication and information sharing. Eagle, Macy and Claxton in 2010 (3) found a strong bond strong between social networking and community development. A question that quickly comes to mind is how the media and social networking can be used to improve on the situation of individuals, groups and communities of Syrian refugees in Lebanon.**** لبان محمد طي : تعدّ أطروحة دكتوراه في علوم الإعلام والاتصال – المعهد العالي للدكتوراه – الجامعة اللبنانية * Loubane Mohammed Tay: is preparing a doctoral thesis in Information and Communication Sciences - Higher Doctorate Institute - Lebanese University
- نبذة عن البحث :
دور وسائل الإعلام الاجتماعية وشبكاتها في تحسين أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان
إنّ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي الجهة المسؤولة عن النازحين السوريين في لبنان، تسجّلهم تحت مسمّى "اللاجئين السوريين"، وتعمل على حمايتهم وتأمين احتياجاتهم، وهو ما حقّقته مستعينةً بمعلومات جُمعت على شبكات الإعلام الاجتماعية صُمّمت لهذه الغاية. فلقد تمكنت المفوضيّة من خلق شبكات تواصل اجتماعي تصل إلى غالبية النازحين، وتسمح بالتواصل وتبادل المعلومات معهم، وبنشر دراسات وتقارير حول وضعهم، والتنسيق مع السلطات اللبنانية المحلية ومؤسسات المجتمع المدني المحليّة والدوليّة لتلبيت اجتياجاتهم.وهنا نسأل: كيف يمكن استخدام هذه الوسائل لتنظيم شؤون اللاجئين السوريين في لبنان وتحسين أوضاعهم، بالرغم من ظروفهم الدقيقة من ناحية الحفاظ على خصوصيّة البيانات المرتبطة بالنازحين، ومن صعوبة وضعهم الأمني، والاجتماعي، والاقتصادي والصحي؟الكلمات المفتاحيّة: شبكات ووسائل الإعلام الاجتماعية - النازحين / اللاجئين السوريين – تنظيم داتا معلومات - تواصل وتبادل المعلومات - خصوصية البيانات.***For years, Lebanon has remained the country hosting the largest number of refugees per capita. According to a 2021 UNHCR report, the country has about 891,300 registered refugees with 97.1% of them originating from Syria and the others of Palestinian, Iraqi, Sudanese and other origins (1), in 2020, the total number of refugees in Lebanon was estimated to be more than a million and a half, an equivalent of about one third of the country’s total population.The massive influx of Syrian refugees ever since 2011 into the country has been exerting considerable pressure on different sectors such as security, labour market, health, and education services. The refugee crisis is further complicated by the age-groups and gender diversity as well as the different vulnerabilities that create networking and communication challenges among the refugee population and with their host communities.Given the situation, the Lebanese government instructed the UNHCR to suspend the registration of refugees at the beginning of 2015. This singular decision has been creating such information gap on the real number of persons fleeing from war zones, and leaving unregistered children, women, elderly persons, and persons living with disabilities, exposed to further vulnerabilities. Current events have been hitting hard, thereby making the refugee crisis in Lebanon a protracted one. The country registered a full-blown economic crisis. Years of decelerated growth meant a halt on subsidization in the social domain, reduced investment in infrastructural development. This resulted in further neglect on the needs of refugees.(2)The protracted nature of the situation in Lebanon and with limited self reliance possibilities are having serious tolls on refugee. The use of social media and social networking has become a veritable force in fighting poverty and building communities through communication and information sharing. Eagle, Macy and Claxton in 2010 (3) found a strong bond strong between social networking and community development. A question that quickly comes to mind is how the media and social networking can be used to improve on the situation of individuals, groups and communities of Syrian refugees in Lebanon.**** لبان محمد طي : تعدّ أطروحة دكتوراه في علوم الإعلام والاتصال – المعهد العالي للدكتوراه – الجامعة اللبنانية * Loubane Mohammed Tay: is preparing a doctoral thesis in Information and Communication Sciences - Higher Doctorate Institute - Lebanese University
Published on July 15, 2021 12:27
جرÙØ Ø§ÙÙ Ø®ÙÙØ© اÙعربÙØ© - Ù Ùاربة Ù٠٠ضا٠Ù٠اÙشعر اÙØدÙØ« ÙÙضاÙاÙ

♦ كامل فرحان صالح *
- نبذة عن البحث:
تأثر الأدب العربي الحديث والمعاصر بالحداثة الغربية، بدءًا من أواخر القرن التاسع عشر، وبدا هذا التأثر جليًّا في أدب أمين الريحاني (1876 – 1940)، وأعضاء الرابطة القلمية في المهجر، وفي مدرستي "الديوان" و"أبولو" في مصر، وقد ظهر أوئل النصف الأول من القرن العشرين، ما دعي باسم "حركة الشعر الحر" أو "قصيدة التفعيلة" في العراق ممثلة بالشعراء بدر شاكر السياب (1926 – 1964)، ونازك الملائكة (1923 – 2007)، وبلند الحيدري (1926 – 1996)، وعبد الوهاب البياتي (1926 – 1999)، وظهر في لبنان جماعة "مجلة شعر" التي عنيت بالتحديث عبر كتابة هذه القصيدة، و"قصيدة النثر" ونشرها والتنظير لها، وترجمة الأشعار الأجنبية والدراسات النقدية، وضمّت هذه المجلة شعراء لبنانيين وعرب، أبرزهم:يوسف الخال (1916 – 1987)، وعلي أحمد سعيد اسبر (أدونيس) (1930)، وخليل حاوي (1919 – 1982)، وأنسي الحاج (1937 – 2014)، والسياب، ومحمد الماغوط (1934 – 2006)، وفؤاد رفقة (1930 – 2011)، وشوقي أبي شقرا (1935)...لم يقتصر التحديث في القصيدة العربية على مستوى التأثير الغربي فحسب، بل جاء ليعبر عن واقع مأزوم في ظل تحولات عمودية وجوهرية شهدها العالم العربي بعد نهاية الحكم العثماني، وسيطرة الغرب مباشرة على مقدرات الدول العربية عبر الانتداب، وقد اشتدت ضبابية المشهد مع نكبة فلسطين في العام 1948، لتترسخ جروح المخيلة عميقًا في القصيدة شكلاً ومضمونًا، فبرزت على السطح موضوعات جديدة لم تكن حاضرة أو مألوفة في تاريخ الشعر العربي من قبل، وبهتت صور التغني بالجمال، والطبيعة وسحرها، وسادت القصيدة لغة شعرية أيقوناتها: الرموز، والأساطير، والشخصيات الدينية والتاريخية والشعبية...يقارب هذا البحث إذًا، هذا الحراك الشعري الحديث الذي شهده العالم العربي، فيقدم بدايةً مقاربة لأبرز المحطات في هذا الحراك، ثم يلقي الضوء على أبرز قضايا الشعر العربي الحديث ومضامينه من خلال نماذج شعرية مختارة، ثم يطرح في المحصلة والاستنتاج أبرز ما ورد في البحث، مقدمًا في الوقت نفسه، بعض الخلاصات التي يمكن البناء عليها في أبحاث مستقبلية.**** أستاذ في الجامعة اللبنانية
مجلة الحداثة - ربيع 2021 - عدد 215 /216 - Al Hadatha Journal
Published on July 15, 2021 12:18
جروح المخيلة العربية - مقاربة في مضامين الشعر الحديث وقضاياه

♦ كامل فرحان صالح *
- نبذة عن البحث:
تأثر الأدب العربي الحديث والمعاصر بالحداثة الغربية، بدءًا من أواخر القرن التاسع عشر، وبدا هذا التأثر جليًّا في أدب أمين الريحاني (1876 – 1940)، وأعضاء الرابطة القلمية في المهجر، وفي مدرستي "الديوان" و"أبولو" في مصر، وقد ظهر أوئل النصف الأول من القرن العشرين، ما دعي باسم "حركة الشعر الحر" أو "قصيدة التفعيلة" في العراق ممثلة بالشعراء بدر شاكر السياب (1926 – 1964)، ونازك الملائكة (1923 – 2007)، وبلند الحيدري (1926 – 1996)، وعبد الوهاب البياتي (1926 – 1999)، وظهر في لبنان جماعة "مجلة شعر" التي عنيت بالتحديث عبر كتابة هذه القصيدة، و"قصيدة النثر" ونشرها والتنظير لها، وترجمة الأشعار الأجنبية والدراسات النقدية، وضمّت هذه المجلة شعراء لبنانيين وعرب، أبرزهم:يوسف الخال (1916 – 1987)، وعلي أحمد سعيد اسبر (أدونيس) (1930)، وخليل حاوي (1919 – 1982)، وأنسي الحاج (1937 – 2014)، والسياب، ومحمد الماغوط (1934 – 2006)، وفؤاد رفقة (1930 – 2011)، وشوقي أبي شقرا (1935)...لم يقتصر التحديث في القصيدة العربية على مستوى التأثير الغربي فحسب، بل جاء ليعبر عن واقع مأزوم في ظل تحولات عمودية وجوهرية شهدها العالم العربي بعد نهاية الحكم العثماني، وسيطرة الغرب مباشرة على مقدرات الدول العربية عبر الانتداب، وقد اشتدت ضبابية المشهد مع نكبة فلسطين في العام 1948، لتترسخ جروح المخيلة عميقًا في القصيدة شكلاً ومضمونًا، فبرزت على السطح موضوعات جديدة لم تكن حاضرة أو مألوفة في تاريخ الشعر العربي من قبل، وبهتت صور التغني بالجمال، والطبيعة وسحرها، وسادت القصيدة لغة شعرية أيقوناتها: الرموز، والأساطير، والشخصيات الدينية والتاريخية والشعبية...يقارب هذا البحث إذًا، هذا الحراك الشعري الحديث الذي شهده العالم العربي، فيقدم بدايةً مقاربة لأبرز المحطات في هذا الحراك، ثم يلقي الضوء على أبرز قضايا الشعر العربي الحديث ومضامينه من خلال نماذج شعرية مختارة، ثم يطرح في المحصلة والاستنتاج أبرز ما ورد في البحث، مقدمًا في الوقت نفسه، بعض الخلاصات التي يمكن البناء عليها في أبحاث مستقبلية.**** أستاذ في الجامعة اللبنانية
Published on July 15, 2021 12:18
Lâapprentissage de la femme dans la littérature algérienne féminine et masculine pré/post coloniale
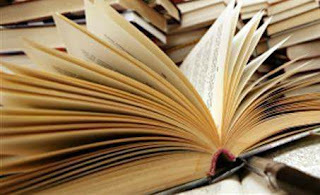
♦ Amina TAHRAOUI *
♦ Rachida SADOUNI **
♦ Fatiha RAMDANI ***
- نبذة عن البحث باللغة العربية:
تعلّم الإناث في الأدب الجزائري مقارنة بالذكور قبل الاستقلال وبعده
يهدف هذا المقال إلى تحليل موضوع تعّلم الإناث مقارنة بالذكور في الأدب الجزائري؛ فيعالج موضوع تعليم المرأة الجزائرية في المجتمع الذكوري قبل الاستقلال وبعده باستعمال مدونة متنوعة من الروايات المكتوبة باللغة العربية والفرنسية، حيث جرى تحليل بعض الأعمال الروائية النسائية والرجالية في ما يتعلق بتعلم المرأة في مجتمع يهيمن عليه الذكور.الاشكالية المركزية للبحث هي: كيف يعالج الأدب الجزائري موضوع تعليم المرأة من خلال المنظور الأنثوي والمنظور الذكوري وبالموازاة مع تعليم الرجل؟الكلمات الرئيسة: التعلم، الأدب الجزائري، المرأة، الاستقلال، الجزائر.***- Résumé: Notre article se propose d’analyser le thème de l’apprentissage de la femme comparé à l’homme, dans la littérature algérienne. A travers un corpus varié de romans algériens d’expression française et arabe, il s’agit d’exposer l’éducation de la femme algérienne au sein de la société patriarcale pré-indépendante et post-indépendante. Nous aspirons essentiellement à démontrer comment est exprimée l’éducation de la femme dans la littérature algérienne, selon deux perspectives: masculine et féminine, et en juxtaposition avec celle de l’homme.Nous analyserons des œuvres romanesques féminines et masculines pour ce qui est de l'apprentissage de la femme dans une société à dominante masculine.- Mots-clés: Apprentissage, littérature algérienne, femme, indépendance, Algérie***- Abstract: This paper analyzes the theme of females’ learning compared with males, in Algerian literature. Through a varied corpus of Algerian novels of French and Arabic expression, this paper aims at exposing the education of Algerian women within the pre-independent and post-independent patriarchal society. In essence, we aspire to demonstrate how Algerian literature deals with the theme of woman's education from two perspectives: masculine and feminine, and in parallel with that of man.We will analyze feminine and masculine fiction works regarding woman’s learning in a male-dominated society.- Keywords: Learning, Algerian literature, woman, independence, Algeria***
* Dr. Amina TAHRAOUI, maitre de conférences, Université princesse Nourah Bint Abdelrahman
- د. أمينة طهراوي: أستاذة مساعدة - قسم الترجمة، كلية اللغات - جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن- الرياض، المملكة العربية السعودية
** Dr. Rachida SADOUNI, maître de conférences, Département de français, université Blida 2 .
- د. رشيدة سعدوني: أستاذة محاضرة - قسم اللغة الفرنسية، كلية الآداب واللغات-جامعة البليدة 2
*** Dr. Fatiha RAMDANI, maître de conférences au département de sociologie, université Alger 2 Abou El Kacem Saadallah.
- د. فتيحة رمضاني: أستاذة محاضرة -قسم علم الاجتماع، كلية العلوم الاجتماعية- جامعة الجزائر2 أبو القاسم سعد الله.
مجلة الحداثة - ربيع 2021 - عدد 215 /216 - Al Hadatha Journal
Published on July 15, 2021 12:11
L’apprentissage de la femme dans la littérature algérienne féminine et masculine pré/post coloniale
♦ Amina TAHRAOUI *
♦ Rachida SADOUNI **
♦ Fatiha RAMDANI ***
- نبذة عن البحث باللغة العربية:
تعلّم الإناث في الأدب الجزائري مقارنة بالذكور قبل الاستقلال وبعده
يهدف هذا المقال إلى تحليل موضوع تعّلم الإناث مقارنة بالذكور في الأدب الجزائري؛ فيعالج موضوع تعليم المرأة الجزائرية في المجتمع الذكوري قبل الاستقلال وبعده باستعمال مدونة متنوعة من الروايات المكتوبة باللغة العربية والفرنسية، حيث جرى تحليل بعض الأعمال الروائية النسائية والرجالية في ما يتعلق بتعلم المرأة في مجتمع يهيمن عليه الذكور.الاشكالية المركزية للبحث هي: كيف يعالج الأدب الجزائري موضوع تعليم المرأة من خلال المنظور الأنثوي والمنظور الذكوري وبالموازاة مع تعليم الرجل؟الكلمات الرئيسة: التعلم، الأدب الجزائري، المرأة، الاستقلال، الجزائر.***- Résumé: Notre article se propose d’analyser le thème de l’apprentissage de la femme comparé à l’homme, dans la littérature algérienne. A travers un corpus varié de romans algériens d’expression française et arabe, il s’agit d’exposer l’éducation de la femme algérienne au sein de la société patriarcale pré-indépendante et post-indépendante. Nous aspirons essentiellement à démontrer comment est exprimée l’éducation de la femme dans la littérature algérienne, selon deux perspectives: masculine et féminine, et en juxtaposition avec celle de l’homme.Nous analyserons des œuvres romanesques féminines et masculines pour ce qui est de l'apprentissage de la femme dans une société à dominante masculine.- Mots-clés: Apprentissage, littérature algérienne, femme, indépendance, Algérie***- Abstract: This paper analyzes the theme of females’ learning compared with males, in Algerian literature. Through a varied corpus of Algerian novels of French and Arabic expression, this paper aims at exposing the education of Algerian women within the pre-independent and post-independent patriarchal society. In essence, we aspire to demonstrate how Algerian literature deals with the theme of woman's education from two perspectives: masculine and feminine, and in parallel with that of man.We will analyze feminine and masculine fiction works regarding woman’s learning in a male-dominated society.- Keywords: Learning, Algerian literature, woman, independence, Algeria
***
1. * Dr. Amina TAHRAOUI, maitre de conférences, Université princesse Nourah Bint Abdelrahman- د. أمينة طهراوي: أستاذة مساعدة - قسم الترجمة، كلية اللغات - جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن- الرياض، المملكة العربية السعودية** Dr. Rachida SADOUNI, maître de conférences, Département de français, université Blida 2 .- د. رشيدة سعدوني: أستاذة محاضرة - قسم اللغة الفرنسية، كلية الآداب واللغات-جامعة البليدة 2*** Dr. Fatiha RAMDANI, maître de conférences au département de sociologie, université Alger 2 Abou El Kacem Saadallah.- د. فتيحة رمضاني: أستاذة محاضرة -قسم علم الاجتماع، كلية العلوم الاجتماعية- جامعة الجزائر2 أبو القاسم سعد الله.
♦ Rachida SADOUNI **
♦ Fatiha RAMDANI ***
- نبذة عن البحث باللغة العربية:
تعلّم الإناث في الأدب الجزائري مقارنة بالذكور قبل الاستقلال وبعده
يهدف هذا المقال إلى تحليل موضوع تعّلم الإناث مقارنة بالذكور في الأدب الجزائري؛ فيعالج موضوع تعليم المرأة الجزائرية في المجتمع الذكوري قبل الاستقلال وبعده باستعمال مدونة متنوعة من الروايات المكتوبة باللغة العربية والفرنسية، حيث جرى تحليل بعض الأعمال الروائية النسائية والرجالية في ما يتعلق بتعلم المرأة في مجتمع يهيمن عليه الذكور.الاشكالية المركزية للبحث هي: كيف يعالج الأدب الجزائري موضوع تعليم المرأة من خلال المنظور الأنثوي والمنظور الذكوري وبالموازاة مع تعليم الرجل؟الكلمات الرئيسة: التعلم، الأدب الجزائري، المرأة، الاستقلال، الجزائر.***- Résumé: Notre article se propose d’analyser le thème de l’apprentissage de la femme comparé à l’homme, dans la littérature algérienne. A travers un corpus varié de romans algériens d’expression française et arabe, il s’agit d’exposer l’éducation de la femme algérienne au sein de la société patriarcale pré-indépendante et post-indépendante. Nous aspirons essentiellement à démontrer comment est exprimée l’éducation de la femme dans la littérature algérienne, selon deux perspectives: masculine et féminine, et en juxtaposition avec celle de l’homme.Nous analyserons des œuvres romanesques féminines et masculines pour ce qui est de l'apprentissage de la femme dans une société à dominante masculine.- Mots-clés: Apprentissage, littérature algérienne, femme, indépendance, Algérie***- Abstract: This paper analyzes the theme of females’ learning compared with males, in Algerian literature. Through a varied corpus of Algerian novels of French and Arabic expression, this paper aims at exposing the education of Algerian women within the pre-independent and post-independent patriarchal society. In essence, we aspire to demonstrate how Algerian literature deals with the theme of woman's education from two perspectives: masculine and feminine, and in parallel with that of man.We will analyze feminine and masculine fiction works regarding woman’s learning in a male-dominated society.- Keywords: Learning, Algerian literature, woman, independence, Algeria
***
1. * Dr. Amina TAHRAOUI, maitre de conférences, Université princesse Nourah Bint Abdelrahman- د. أمينة طهراوي: أستاذة مساعدة - قسم الترجمة، كلية اللغات - جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن- الرياض، المملكة العربية السعودية** Dr. Rachida SADOUNI, maître de conférences, Département de français, université Blida 2 .- د. رشيدة سعدوني: أستاذة محاضرة - قسم اللغة الفرنسية، كلية الآداب واللغات-جامعة البليدة 2*** Dr. Fatiha RAMDANI, maître de conférences au département de sociologie, université Alger 2 Abou El Kacem Saadallah.- د. فتيحة رمضاني: أستاذة محاضرة -قسم علم الاجتماع، كلية العلوم الاجتماعية- جامعة الجزائر2 أبو القاسم سعد الله.
Published on July 15, 2021 12:11
مجلة الحداثة - Al Hadatha Journal
Al Hadatha Journal - A Refereed Academic Quarterly
مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة
تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)
ISSN/2790 Al Hadatha Journal - A Refereed Academic Quarterly
مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة
تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)
ISSN/2790-1785
تُعنى المجلة بنشر الأبحاث الأكاديمية بعد عرضها على لجنة علمية متخصصة. وتبلورت فكرة نشوء المجلة بعد اجتماعات عمل متواصلة بين رئيس تحريرها فرحان صالح وأصدقاء باحثين وأكاديميين من لبنان والعالم العربي، وقد بات عدد منهم ضمن الهيئة الاستشارية للمجلة، علمًا أن بعضهم قد فارق الحياة، وقد جرى إضافة أسماء إلى الهيئة لاحقًا. تغطي مجلة الحداثة الأبحاث التي تأتي من شريحة واسعة من الأكاديميين والمفكرين والكتّاب والأدباء في لبنان والعالم العربي، فتنشر موضوعات تتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والسياسية، كذلك، موضوعات تتعلق بقضايا فكرية وتراثية وأدبية ونقدية وفنية وإعلامية ...more
مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة
تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)
ISSN/2790 Al Hadatha Journal - A Refereed Academic Quarterly
مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة
تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)
ISSN/2790-1785
تُعنى المجلة بنشر الأبحاث الأكاديمية بعد عرضها على لجنة علمية متخصصة. وتبلورت فكرة نشوء المجلة بعد اجتماعات عمل متواصلة بين رئيس تحريرها فرحان صالح وأصدقاء باحثين وأكاديميين من لبنان والعالم العربي، وقد بات عدد منهم ضمن الهيئة الاستشارية للمجلة، علمًا أن بعضهم قد فارق الحياة، وقد جرى إضافة أسماء إلى الهيئة لاحقًا. تغطي مجلة الحداثة الأبحاث التي تأتي من شريحة واسعة من الأكاديميين والمفكرين والكتّاب والأدباء في لبنان والعالم العربي، فتنشر موضوعات تتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والسياسية، كذلك، موضوعات تتعلق بقضايا فكرية وتراثية وأدبية ونقدية وفنية وإعلامية ...more
- مجلة الحداثة's profile
- 11 followers



