مجلة الحداثة's Blog: مجلة الحداثة - Al Hadatha Journal, page 20
October 24, 2021
FINANCIAL INCLUSION A PERSPECTIVE FOR LEBANON


♦ Layla Youssef Tannoury * ♦♦ Mariella Said Afif **
- نبذة عن البحث باللغة العربية:الشمول المالي الموافق للبنان
يعالج هذا البحث أهمية الشمول المالي من حيث التعليم المالي والتخفيف من حدة الفقر وفقًا لأجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة. ويلحظ البحث جميع الجوانب لبناء تقنية Fintech Beam of Light الشاملة من خلال التفكير التصميمي والتقنية العكسية التي تطبق الشمول المالي المسؤول مثل التوازن الدائري والثابت والاقتصاد التشاركي، بالإضافة إلى اقتصاديات الرقمية واقتصاد سلسلة التوريد Blockchain.يشمل البحث ثلاثة استطلاعات كمية استكشافية، تظهر أن اللبنانيين على استعداد لاستخدام، والادخار، والمقايضة من خلال تطبيق إلكتروني للتكنولوجيا المالية.- الكلمات المفاتيح: التقنية المتخلفة، التوازن الثابت والاقتصاد التشاركي، الاقتصاد الدائري، التفكير التصميمي، الشمول المالي، التخفيف من حدة الفقر، أهداف التنمية المستدامة***- ABSTRACT: This research discusses the importance of financial inclusion in terms of financial education and poverty alleviation according to the SDGs 2030 agenda of the United Nations. It emphasizes all aspects to build through design thinking and backward technique the comprehensive fintech Beam of Light that applies responsible financial inclusion such as circular, static equilibrium, and sharing economy in addition to the economics of digitization, and blockchain supply chain economy. It encompasses three explorative quantitative surveys. The surveys show that Lebanese are willing to use, save, and barter through a fintech electronic application.- Key words: Backward Technique, Static Equilibrium and Sharing Economy, Circular Economy, Design Thinking, Financial Inclusion, Poverty Alleviation, SDGs, Beam of Light**** د. ليلى يوسف تنوري : دكتورة في إدارة الأعمال والإدارة الصحية والاقتصاد الصحي – الجامعة اللبنانية* Layla Youssef Tannoury: Associate Professor of Business Administration and Public Health Administration - Lebanese University
Dr. Layla Tannoury is an experienced and passionate leader, professor, and researcher in business administration and health economics. Driven by the thrill of knowledge and her love for her students, she takes pride in providing the best education and expertise as possible. Her goals include inciting innovation, curiosity, and unleashing the power of creativity in her students. In addition, Dr. Tannoury has great commitment to create new economic and financial models instigating entrepreneurship as feeling socially responsible.
** مارييللا سعيد عفيف : باحثة مستقلة وخبيرة في بناء منطق التكنولوجيا المالية. أمضت عدة سنوات في العمل على التمويل الأصغر والشمول المالي.* Mariella Said Afif: CEO of Responsible Sustainable Solution, RSS, s.a.r.l. Consultant – Logic Builder – Independent Researcher
Mariella Afif is a self-made brave and resilient researcher and fintech logic builder and expert. Mariella Afif has spent several years working on microfinance and financial inclusion. Mariella, is the creator and designer of Beam of Light, the trademark for the comprehensive financial technology. She is a consultant for several municipalities, municipality unions, and SMEs for several projects like PV farms, company branding, and export consulting. She works with youth councils and involves them in community-based projects.*** مجلة الحداثة - صيف/خريف 2021 - عدد 217 /218 - Al Hadatha Journal
Published on October 24, 2021 08:51
"فن العيش الحكيم" لشوبنهاور: التجربة هي النّص والتفكير هو الحاشية

 هيثم فرحان صالح
هيثم فرحان صالح

هيثم فرحان صالح *
إنّ كتاب "فن العيش الحكيم" للفيلسوف الألماني "أرثور شوبنهاور (1788 – 1860/ Arthur Schopenhauer) الغنيّ عن التعريف، هو عبارة عن طرح لنموذج حياة، ويحمل مجموعة من القواعد والمسلّمات الواجب اتّباعها والعمل بها. هذه القواعد، وتلك المسلّمات، تندرج تحت إطار قناعات فكريّة تولّدت لدى شوبنهاور، وهي مرتبطة بتجربته وظروف حياته.وُسم شوبنهاور بالتشاؤم، وكان له تأثير كبير لاحق على فلاسفة ذلك العصر، وإلى الآن هناك كثيرون يعيدون قراءة شوبنهاور وطروحاته.لقد تأثر بشوبنهاور الفيلسوف "فريدريك نيتشه (1844- 1900/Friedrich Nietzsche) وهو عادةً ما أشار إلى ذلك، بكتاباته ومؤلفاته العديدة، فلقد مثّل شوبنهاور حالة خاصة في الفلسفة، وهو حصل على الدكتوراه فيها في سن صغيرة نسبيّا (في الخامسة والعشرين)، وشهدت حياته الخاصّة الكثير من المنعطفات الصعبة والقاسية. ظروف حياته الخاصّة، كان لها الكثير من التداعيات اللاّحقة التي أثّرت على مختلف مراحل حياته، وساهمت تلك الظروف، والأحداث التي عايشها وخبرها، في تشكيل آرائه وأفكاره تجاه الحياة والعلاقات الاجتماعيّة من جهة، وباتجاه الإطار الثقافي والفكري في النصف الأول من القرن التاسع عشر الذي كان غنيًّا بالطروحات الفكرية والفلسفيّة والثقافيّة من جهة أخرى.تأثّر شوبنهاور منذ البدايات، بالعديد من الأحداث المؤلمة، حيث انتحر والده وكان شوبنهاور لم يتجاوز السابعة عشر من عمره، وما لبثت أمه أن فارقته لتعيش بعيدًا منه في نمط حياة متحرّرة وخالية من أيّ وازع ديني أو أخلاقي، ما جعل علاقته معها، وفي مختلف مراحل حياته، تحمل توتّرًا شديدًا، وإشكالات عميقة. رأى شوبنهاور أنّ تصرّفات والدته تتّصف بالأنانية، واللاأخلاقيّة، وتعدّ مثالًا ونموذجًا للمرأة الغاوية واللامسؤولة والانتهازيّة... إلخ. ترك ذلك جرحًا نفسيًّا غائرًا، وأثّر على علاقة شوبنهاور بالمرأة، وعلى الكثير من أفكاره تجاه النّساء عمومًا.الكلام على شوبنهاور قد يحتاج إلى الكثير من المجلّدات، للإحاطة بما طرحه وقدّمه في مؤلفاته، لكنّنا هنا نكتفي بالإضاءة على ما جاء هذا الكتاب القيِّم.يذكر شوبنهاور في هذا الكتاب أنّ أرسطو قد قسّم الخيرات في حياة الناس إلى ثلاثة أنواع: خيرات ماديّة، وخيرات معنويّة، وخيرات بدنيّة. اعتقد شوبنهاور استنادًا إلى هذا التقسيم الثلاثي، أنّ الحياة البشرية محكومة عمومًا بثلاثة شروط وهي:الكينونة: أي ما نحن إياه، ولها صلة بشخصيّة الإنسان، بمعناها الشامل، وتشمل الصحّة والقوّة والجمال والمزاج والطبع الأخلاقي والذكاء.الحيازة: أي ما عندنا، أو ما نملكه من أشياء.التمثّلات: أي ما تُمثّله في أعين الآخرين وموازينهم، أو بالأحرى، الطريقة التي يتمثّلنا بــــها الآخرون، والدالّة على مدى تقديرهم لنا مــن عدمه، وهو ما يتبيّن من خلال آرائهم التقديرية التي يصنفون الناس اعتمادًا عليها، القائمة على معايير الشرف والمكانة والمجد (ص15 من الكتاب).ركّز شوبنهاور على المستوى الأول، أو الشرط الأوّل المحكوم بالكينونة، ورأى أنّ اختلافات الكينونة المتعلقة بكل شخص، بصفته فردًا، لها التأثير الحاسم على سعادته أو تعاسته، وذلك بالمقارنة مع الشروط الأخرى التي هي من وضع الناس، والمندرجة في المستويين الثاني والثالث، فالمزايا الشخصيّة التي تشمل العقل الراجح، والقلب الكبير، شبيهة بالملوك الحقيقيّين، بينما مثيلاتها ذات الصلة بالمقام أو النسب الملكي، والثروة وما شابه، أشبه ما يكون بمن يمثل دور الملك على خشبة المسرح، حتى ولو كان ملكًا بالنّسب، كما ذكر شوبنهاور. فالأساس في سعادة الفرد، من عدمها، هو قطعًا، ما يحدث بدواخله، وما يعمل في قرارة نفسه، ذلك أنّ كلّ فرد هو محكوم بحركته الإرادية، وهو نتاج مباشر لمداركه وأحاسيسه، أما الأشياء الخارجية العارضة فتأثيرها عليه مشروط بأحواله الداخلية.فكلّ واحد منّا محكوم بطريقة إدراكه للأشياء، وهذه الطريقة تختلف من شخص لآخر باختلاف الذكاء والتجارب لاحقًا. والسبب في كلّ ذلك، أنّ كل واقع أو حدث، يتشكل من شقين: الذات والموضوع، وبطبيعة الحال إنّ الذات تتمثل بالواقع بشكل مختلف تبعًا لكل فردٍ، فكل واحد منّا منغلق في وعيه الذاتي، ولا يعيش على نحو مباشر إلا من داخله، رغم امتزاج الذات بالموضوع، والتساوي بالأهميّة، إلاّ أنّ الذاتي متباين، ويأتي دومًا على نحو مختلف، بينما الموضوعي يأتي مطابقًا دائمًا لذاته.فعلى خشبة المسرح، يتقمّص الأمراء والمستشارون والخدم والجند والجنرالات، وغيرهم، أدوارًا مختلفة، غير انّ هذا الاختلاف لا يطال إلا مظهرهم الخارجي، أما دواخلهم فتبقى على حالها بما هي نواة كلّ شخص (ص17 من الكتاب). ومن المؤكد بحسب شوبنهاور، أنّ الذاتي أهم بكثير من الموضوعي في الإنسان وعليه الأساس في توفير سعادته، وخلق متعِه في كلّ مناحي الحياة. فالشرط الأول، والجوهري لسعادتنا، هو ما نحن إياه، وهو طبعنا أولًا وأخيرًا، فهو الذي يؤثر فينا على نحو مباشر، وفي كلّ الظروف.يورد شوبنهاور في معرض حديثه عن فن العيش، قاعدة سامية لكل حكمة ممكنة في هذه الدنيا، وهي ما قاله أرسطو في كتاب: "الأخلاق إلى نيقاموس"، والقاعدة هي: غاية الحكيم ليست حياة مُترعةً في اللّذة، بل خالية من الألم (ص58).ويستند جوهر هذه الحكمة على حقيقة ترى أنّ كــــل لذة (متعة)، وكـــــل ســــعادة ذات طبيعة سالبة، بينما الألم ذو طبيعة موجبة. فالمعرفـــة المجـــــــردة خالية مــــــن الألم، وكلما كانت لــــــها الغلبة والأرجحية في التصوّر البشري كان المرء أسعد المخلوقات (ص63)، والدّليل على ذلك، أنّ كل متعة سالبة بطبيعتها، وكل ألم موجب بطبيعته.ويلحظ شوبنهاور أن أبيقور قسّم الحاجات الأساسية تقسيمًا رائعًا من خلال تحديد لها في ثلاثة أنواع:1ـ الحاجات الطبيعيّة الضروريّة، إن لم تُشبع كانت مصدرًا للألم، وتشمل الحاجة إلى الغذاء والكساء، وكلّ الحاجات التي يتيسّر إشباعها.2 ـ الحاجات الطبيعيّة غير الضروريّة، وتشمل الحاجة الجنسيّة، وهي حاجة غير متيسّرة الإشباع دائمًا.3 ـ الحاجات غير الطبيعيّة وغير الضرورية، وتشمل الحاجة إلى الترف والبذخ والإحساس بالعظمة والأبهة، وما شابه، وإشباعها غير متيسّر، وبالغ الصعوبة.يرى شوبنهاور أنّ المجهود الذي يبذله الإنسان للرفع من سقف مطامعه ومطامحه، مصدر كلّ مشاعر السخط والاستياء التي تخالجه، ذلك أنّ المجهود الجبار غالبًا ما يصطدم بعقبات تعترضه، وتحول دون الوصول إلى مراده. فلا غرابة إذًا، أنّ الناس يحبون المال حبًّا جمًّا، فهم في غدوهم ورواحهم، وفي كدّهم وتدافعهم، يرفعون من قدره لأنّ حياتهم يسحقها الفقر والعوز، وتمور بالحاجات المرغوبة والمشتهاة، فحتى السلطة لا قيمة لها في موازينهم إن لم تجلب مالًا وثروة (ص65). لذا، ليس علينا أن نندهش عندما يضربون بعرض الحائط كل الاعتبارات الأخلاقيّة في سعيهم المحموم نحو كسب المال والاستزادة منه.من جهة أخرى، يرى شوبنهاور أنّ النبيل في فترة شبابه، يتوهم أنّ التحلي بالأخلاق الفاضلة والذوق الرفيع، والذكاء الوقّاد، والمحترميّة، خصال يمكن أن تجمع الناس، لكن مع التقدم في السنّ، يكتشف أنّ الكلمة الفصل في العلاقات البشريّة، هي دائمًا للاعتبارات المادية التي توجّهها المصالح والمنافع، فالانغشالات الماديّة الصَّرفة، هي أساسها وقوامها. إنّ الإنسان لذاته وفي ذاته، لا يعتدّ بها إلا عرضًا، وعلى سبيل الاستنئاس، ومن باب المتعة، فأغلب الناس يضعون المناقب البشريّة على الرّف.يلحظ شوبنهاور من جانب آخر، أنّ الشعور القومي شعور زائف؛ فالشخص وُجد بمحض الصّدفة في أمّته، وبالتالي، إنّ الشعور القومي هذا، شعور زائف، ويرى أنّ شعارات الشّرف والوفاء هنا تعبّر عن ما سمّاه، الضمير الخارجي، بينما الضمير الحقيقي هو الشعور والشّرف الداخلي للشخص، ولا يتعلّق بمكانه، أو جنسيّته.إنّ الأحداث والمغامرات والوقائع السعيدة والتعيسة، على الرغم من غزارتها وتكاثرها، شبيهة بمصنوعات الحلواني التي تجد فيها ذات الأشكال الملتوية أو المبرقعة وغيرها، علمًا بأنّها مصنوعة كلها من عجينة واحدة. فالعناصر المكوّنة للوجود البشري تظل على حالها، على الرغم من أشكالها المتعدّدة والوافرة، فشروط حدوثها كذلك تبقى هي هي، سواء عاش الإنسان في كوخ ضيّق، أم في قصر فاخر، أم في دير أو ثكنة.فما حدث اليوم لزيد، مماثل لما حدث بالأمس لعمر، ومع ذلك اقترفه زيد مجددًا على علاته. فالحياة أشبه بقطعة قماش مطرَّزة، لا يرى الغُرّ، إلا وجهها في الشطر الأول من حياته، وفي شطرها الثاني، فقط، ينظر إلى ظهرها، أو قفاها، الأقلّ جمالًا وجذبًا للنظر. فالوجه الخلفي هو الأكثر إفادة رغم ذلك، فهو الحقيقة، إذ على سطحه تترابط، وتتشابك الخيوط الناسجة له (للثّوب).ففي الأربعينيّات من عمر الإنسان يكون للتفوّق الفكري، السلطة والغلبة، نتيجة اكتسابه للتجارب والخبرات التي تتجاوز الذّكاء. فالتجربة هي النّص، بينما التفكير والمعرفة هما التّعليق والتعقيب على النّص، التجربة هي النّص، والتفكير هو الحاشية (ص80).وكلّ من جبته الطبيعة بالتميّز العقلي، يميل إلى العزلة الشعوريّة والعقليّة عن العوام الذين يمثلون ثلثي البشرية، حيث تعلوه غلالة من النفور من بني البشر، ويميل تلقائيًا إلى تفاديهم ما أن تخطّى عتبة الأربعينيات من عمره، فقد خالطهم وشبع من معاشرتهم، وعرفهم حقّ المعرفة، ثمّ وضع كل واحد منهم في منزلته الحقّة، ولم تعد تنطلي عليه الأكاذيب والمظاهر الخدّاعة.الشاب في مقتبل العمر، يكون مقبلًا على جلبة الناس وتدافعهم، منخرطًا في مكائدهم ودسائسهم، بل ويجد فيها الراحة والعزاء، تراه منسجمًا فيها كما لو كانت من فطرته وسجيّته التي بها خُلق.غير أنّ الشاب من هذه الطينة، لا يبشّر بخير، إذ يعطي الدليل بسلوكه على نزعته السّوقيّة، وميله الطبيعي إلى حياة الغوغاء، عكس الشاب الذي يبدو حائرًا، شاردًا، متردّدًا وعديم الحيلة وسط جمهرة الناس، وهذا الشاب يرسل إشارات عفوية على سموّه، وعلى نبله وندرة معدنه (ص289).بالمقابل، لا يتحصّل المرء على دراية عميقة بالأشياء، وحقائقها وكنهها بفضل استغراقه في التأملات، بل بفضل الحدوس الذي من خلاله يدرك الأشياء بلا وسائط، اي إدراكًا حسيًّا مباشرًا متأتيًا من الأثر اللحظي الذي تُحدثه الأشياء والموضوعات فيه. فالحدوس، بهذا المعنى، مشروط بانطباعات نافذة، شديدة الحيوية وعميقة الغور.ويشير إلى أن الإنسان في شبابه ميّالٌ إلى الاستغراق في التأمّلات الجانبية، وعند اكتمال نضجه، يشتدّ ميله إلى التفكّر والتدبّر، فالشّباب هو زمن الشعر والشرود الذهني، بينما النضج هو زمن التفلسف والفلسفة.يورد شوبنهاور تلك الحكمة عمّا يدير العالم، فالعالم تدبّره قوى ثلاث: الحذر، والقوّة، والحظ، ويرى أنّ الحظّ هو الصدفة في هذه القسمة. فإذا كان هذا العالم كسفينة تمخر عباب البحر، القدر فيه، هو الرياح الدافعة بقوة للسفينة إلى الأمام، أو إلى الخلف، وكلّ المجهودات أحيانًا، التي يبذلها ربّان السفينة لتغيير اتجاه السفينة، وللتخفيف من دفع الرّياح ذات تأثير ضعيف جدًا، أمّا إذا كانت حركة الرياح مساعدة وإيجابية، أي تجري كما تشتهي السّفن، كما يقال، فلا حاجة للإنسان للمجاديف أو لتحريكه لها.إنّ الصدفة لا تني تلقّن الإنسان، أنّ الاستحقاق البشري هو لا شيء في ميزان الصدف ونعمها، هذا هو الدرس من هذا المثال. فالعاقل يقتنع بحقيقة بسيطة مؤداها أنّ مجريات حياة الإنسان هي عصارة عاملين أساسيّين، ولا تتحكم فيها فقط إرادته: أولهما؛ معرفة بتسلسل الأحداث والقرارات التي اتّخذها بشأنها، والتي لا تتوقف عن التفاعل والتشابك، والحال أنّ المعرفة والرؤية البشرية، ومهما بلغت من الكمال، تظلّ محدودة بقدرته على الإدراك، فهي قاصرة عن توقع كل شيء، خصوصًا الأشياء البعيدة، ومن جملتها الحلول المناسبة لمشكلاته هنا، والآن، والتي يجب أن يجنح إليها في اللّحظة المناسبة.ففي معمعة الأحداث، ليس واقعيًّا للإنسان إلاّ اللّحظة الماثلة أمام عينيه، فإذا كان الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه بعيدًا، فسيتعذر عليه منطقيًّا، السير باتجاهه سيرًا مباشرًا ومستقيمًا، وغاية ما يستطيعه، هو تلمّس الطريق الواجب اتباعه بحساب الاحتمالات، أي بالمعادلات الرياضية التقريبيّة. لذا، يتخذ القرار على ضوء الحدث الواقع، والملابسات التي وقع فيها، وفي سياقها، ويحذوه أمل دائم في اتخاذ القرار السليم، الكفيل، بتقريبه أكثر فأكثر من الهدف الذي وضعه نصب عينيه.يجوز تشبيه الأحداث التي تعترض الإنسان في حياته من جهة، والأهداف التي يسعى إليها ولتحقيقها من جهة أخرى، بقوّتين تسيران باتّجاهَين متعاكسَين، فحياته كلّها ليست سوى المحطة الأخيرة التي تستقرّ فيها هاتان القوّتان. إنّ الأحداث الطارئة والأهداف المرسومة، هي التي تُشكّل، من خلال تفاعلها، عُصارة المسار الحياتي للإنسان، ومآله الأخير والنهائي.فالحياة لعبة نرد، إن لم تحصل على العدد الذي تريد، اقنع بما وضعه القدر بين يديك.ويستدرك قائلاً: إلاّ أنّ هناك فارقًا جوهريًّا، بين مدارك الخاصة ومدارك العامّة من الناس، فالعوام يمثلون الأخطار المحتملة، انطلاقًا من أحداث مماثلة لها سبق وقوعها، فيقيسونها على هذه الأخيرة، بينما يتمثلها الخاصة أصحاب العقول الراجحة، كما نتمثّل المحتمل الوقوع، عمومًا. فشرط الإحاطة الشاملة بالمحتمل الوقوع هو التوفّر على ملكة الحكم، بينما تمثّله من خلال الحادث سلفًا، ولا يتطلب من صاحبه إلاّ أعمال الحواس.يُسرف المرء في سنوات شبابه، على إنتاج تصورات خيالية حول أشياء وموضوعات هذه الحياة، على حساب المعارف المتينة، والرصينة، التي لا يكاد يكون لها وجود في هذه المرحلة من عمره، أما عند اكتمال نضجه، تكون الغلبة لملكة الحكم على الأشياء، وتقديرها حقّ قدرها، وترجّع كفّة معرفته العميقة والنافذة بها. بيدَ أنّ سنوات الشباب تظلّ، وبلا منازع، هي شجرة المعرفة التي لا يُجنى ثمارها إلا بعد حين، أي بعد انصرام هذه السنوات. فالإنسان لا يصبح معلّمًا محنّكًا إلاّ بعد ولوجه فترة النضج، وهي خلاصة التصوّرات الدقيقة عن هذا العالم، وموضوعاته، واكتسابه لرؤى جوهريّة وأصيلة بصددها. اللافت أنّ الذكاء، خلافًا للطبع والوجدان، تطوله تغيرات في هذه المرحلة من العمر على نحو مطرّد، هذه التغيرات التي تطال التركيبة المادية للذكاء، باتجاه الصعود أو الهبوط، تتحكم فيها المعارف والأفكار والتجارب وملكة إصدار الأحكام.إنّ هذه التركيبة المزدوجة الجامعة بين شق ثابت هو الطبع الإنساني، وشق متغيّر هو الذكاء الإنساني، تكوّن عُرضة، على نحو منتظم، لتغيرات تسير في اتجاهين متعارضين برأي شوبنهاور، وبالتالي، فهي سبب كل التحوّلات التي يمرّ بها الإنسان في حياته، والتبدل الذي يطالب قيمته الرمزيّة ووضعه الاعتباري.في أربعينيّات العمر التي هي "نصُّ الحياة"، تليها السّنوات التي هي متنها، أو شروحات ذلك النَّص. تلك الشروحات التي تمكّن المرء من إدراك المعاني، والمغازي العميقة لمجريات حياته، في تسلسلها، والتي لا بدّ أن تمدّه بالعِبر الغالية، والفوائد الجمّة، التي ستكون له خير زاد في سنوات حياته المتبقيّة. والأكثر إثارة في هذه السيرورة، أنّ المرء يكتشف ذاته لأوّل مرة بعد أن كان يظنّ أنه أعرَف بها من غيره، فيكتشف أنّه جاهل بحقيقتها وأسرارها وألغازها، بل وجاهل بتحقيق الغاية التي كان يلهث لها، والطموحات التي كان يهفو إليها.كلّ هذه الأمور، يخلص شوبنهاور إلى، أنّها لا تنكشف إلاّ عندما يشارف على النّهاية، هذا هو القدر العام لبني البشر، والسيرورة الإجمالية التي تسير وفقها حياتهم.**** هيثم فرحان صالح: باحث لبناني، حائز شهادة الدكتوراه في العلوم السياسيّة.* أرثور شوبنهاور: فن العيش الحكيم، صدر الكتاب أول مرة في العام 1851، وصدر في العربيّة العام 2018 من منشورات ضفاف ـ بيروت، ومنشورات الاختلاف، الجزائر (326 صفحة)، ترجمة عبد الله زارو.
مجلة الحداثة - صيف/خريف 2021 - عدد 217 /218 - Al Hadatha Journal
مجلة الحداثة - al hadatha
Published on October 24, 2021 08:43
•
Tags:
alhadatha, مجلة-الحداثة
Sexual violence in the Lebanese confessional denomination society

♦ Christiane ELKhoury Elias Saliba *
- نبذة عن البحث باللغة العربية:العنف الجنسي في المجتمع اللبناني الطائفي
العنف الجنسي هو نوع يتواجد في مختلف البلدان والمستويات الاقتصادية والاجتماعية منها. وقد سجّلت منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط أدنى وتيرة لخطط العمل الوطنية لمناهضة عنف الشريك الحميم (44 في المائة) والعنف الجنسي (38 في المائة). هناك نقص في سياسات العنف الجنسي في لبنان، ويشكل السياق الطائفي اللبناني عقبة أمام تطبيق سياسات الحماية ضد العنف الجنسي في منطقة متأثرة بالصراعات واللاجئين والحرب.تتناول هذه الدراسة بحثًا أساسيًّا تحليليًّا حول العنف الجنسي في لبنان في إطار المقاربة الاجتماعية البيئية عبر عملية التطبع الاجتماعي. وتهدف إلى دراسة اشكالية العنف الجنسي في لبنان في سياق طائفي يفتقر إلى سياسات الحماية من العنف. يرتبط هذا النوع من العنف ارتباطًا وثيقًا بالمحددات الاجتماعية مثل نظم القانون، والثقافة، وعدم المساواة في المعايير الاجتماعية والجندرية، والتداعيات الإقليمية للحرب، ولا يزال الإفلات من العقاب يمثل مشكلة في لبنان، كما يعدّ القياس الكمي للعنف الجنسي معقدًا في السياقات الاجتماعية والثقافية والدينية الطائفية.تعالج هذه الدراسة النظرية التحليلية المحددات والعوامل الاجتماعية لـلعنف الجنسي في لبنان بالارتباط مع القوانين والعواقب المتعلقة بأزمة الحرب الإقليمية، وأزمة كورونا الصحية. وتستند التوصيات المقترحة إلى شرعة "أوتاوا" الدولية لتمكين الأهل والنساء والأطفال والمجتمع، بالإضافة إلى إشراكهم في السياسات والتغيير البيئي المجتمعي، وبالتالي يجب تطبيق القوانين وسياسات الحماية وفرضها، مع احترام ومراعاة المراجع الدينية وشرعة حقوق الإنسان.الكلمات المفتاحية: العنف الجنسي، المقاربة البيئية الاجتماعية، المجتمع اللبناني الطائفي، العنف القائم على النوع الاجتماعي، جائحة كورونا (كوفيد- 19)***- Abstract: Sexual violence (SV) is the predominant type of violence across all levels of country income status. The Eastern Mediterranean Region reported the lowest frequency of national action plans in addressing intimate partner violence (44%) and SV (38%). There is a lack of SV policy in Lebanon. The Lebanese denominational context is an obstacle for implementing protection policies against SV in a region affected by conflicts, refugees and war. This article describes a fundamental analytical research on SV in Lebanon using the social-ecological approach through the socialization process. The objective is to address SV in Lebanon in a denominational context that lacks protection policies against violence. SV is strongly associated with social determinants such as the rule of law, culture, inequalities in social and gender norms, and the regional implications of war. Impunity remains a problem in Lebanon, and SV is complicated to quantify within the sociocultural and denominational religious contexts. Social determinants of SV in Lebanon are explored in link with the laws and consequences of the regional war crisis and COVID-19. The proposed recommendations are based on the Ottawa Charter for empowering parents, women, children, and society, in addition to engaging them in policy and environmental changes. Relevant laws and protection policies have to be enforced with respect to the religious references and human rights Chart.- Keywords: Sexual violence, social-ecological approach, Lebanese confessional society, Gender-based violence, COVID-19***· كريستيان الخوري الياس صليبا : أستاذة مساعدة في العلوم الاجتماعية (العلوم الاجتماعية والنفسية الاجتماعية) - مديرة كلية الصحة العامة (الفرع الثاني)- مسؤولة عن ماستر في الصحة العامة - التثقيف والتعزيز في الصحة - الجامعة اللبنانيةDr. Christiane ELKhoury Elias Saliba, PhD: Associate Professor in Sociology- Director -Head of Masters in Public Health -Education and Health Promotion -Laboratory CERIPH – FSP2 - Faculty of Public Health – Section II - Lebanese University*** مجلة الحداثة - صيف/خريف 2021 - عدد 217 /218 - Al Hadatha Journal
Published on October 24, 2021 08:28
A Lacanian Analysis on the duality in Mohja Kahfâs The Girl in the Tangerine Scarf


♦ Roudayna Wahib Fayad *
- نبذة عن البحث باللغة العربية: تحليل لاكاني للازدواجية في رواية "الفتاة في الوشاح اليوسفي" لمهجة قحف

ألقت كارثة 11 أيلول (سبتمبر) 2001، بثقلها على كتابات الكتّاب الأمريكيين العرب وخاصة الكتاب المسلمين (Harb, 2012). وتستكشف هذه الدراسة موضوع اندماج المهاجرين العرب والمسلمين في المجتمع الأمريكي وما يرتبط به من معضلات ما بعد أحداث الحادي عشر من أيلول من منظور نفسي.لهذا، فإن الدراسة تهدف إلى تحليل نفسي لازدواجية الهوية في رواية مهجة قحف: الفتاة في الوشاح اليوسفي** من خلال نظرية مرحلة المرآة من قبل لاكان. ويُتبع منهج بحث نوعي يعتمد على التحليل النفسي في محاولة لكشف الأزمة الثقافية التي تعاني منها البطلة في الرواية، والتداعيات النفسية الناتجة عنها.يؤكد التحليل أن الإناث العربيات وخاصة المسلمات، لديهن انقسام في الهوية بسبب الهيمنة والعنصرية في الثقافة المضيفة. ومع ذلك، فإنهن يحاولن سدّ هذا الانقسام من خلال رحلة استكشاف ثقافية تسمح لهن بالتصالح مع صورتهن الأولى في المرآة وفقًا لنظرية المرآة لدى لاكان.الكلمات المفاتيح: عرب، مسلمون، نساء، أمريكا، ازدواجية، لاكان***- Abstract: Evidently, the calamity of 9/11 has laid its weight on the writings of Arab American writers especially the Muslim ones (Harb, 2012). This study explores the subject of the integration of Arab and Muslim immigrants into the American society and its associated dilemmas post 9/11 from a psychological perspective. For that purpose, the study examines the duality in identity in Mohja Kahf’s novel: The Girl in the Tangerine Scarf through a Lacanian lens. A qualitative research methodology based on psychoanalysis is pursued in an attempt to reveal the cross- cultural crisis suffered by the female protagonist and the psychological repercussions that ensue from it. The analysis asserts that Arab females and especially Muslim ones seem to have a schism in identity due to hegemony and racism in their host culture. Yet, they try to bridge this division through a journey of cultural discovery which allows them to reconcile with their first mirror image as per Lacan’s Mirror Stage Theory.- Key words: Arab, Muslim, Women, America, Duality, Lacan**** ردينة وهيب فياض : تُعدّ أطروحة دكتوراه في الأدب الإنكليزي – المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية - الجامعة اللبنانية* Roudayna Wahib Fayad : Preparing a dissertation in English Literature at the Doctoral School of Literature, Humanities, and Social Sciences at the Lebanese University
مجلة الحداثة - صيف/خريف 2021 - عدد 217 /218 - Al Hadatha Journal
Published on October 24, 2021 08:15
•
Tags:
مجلة_الحداثة
A Lacanian Analysis on the duality in Mohja Kahf’s The Girl in the Tangerine Scarf


♦ Roudayna Wahib Fayad *
- نبذة عن البحث باللغة العربية: تحليل لاكاني للازدواجية في رواية "الفتاة في الوشاح اليوسفي" لمهجة قحف

ألقت كارثة 11 أيلول (سبتمبر) 2001، بثقلها على كتابات الكتّاب الأمريكيين العرب وخاصة الكتاب المسلمين (Harb, 2012). وتستكشف هذه الدراسة موضوع اندماج المهاجرين العرب والمسلمين في المجتمع الأمريكي وما يرتبط به من معضلات ما بعد أحداث الحادي عشر من أيلول من منظور نفسي.لهذا، فإن الدراسة تهدف إلى تحليل نفسي لازدواجية الهوية في رواية مهجة قحف: الفتاة في الوشاح اليوسفي** من خلال نظرية مرحلة المرآة من قبل لاكان. ويُتبع منهج بحث نوعي يعتمد على التحليل النفسي في محاولة لكشف الأزمة الثقافية التي تعاني منها البطلة في الرواية، والتداعيات النفسية الناتجة عنها.يؤكد التحليل أن الإناث العربيات وخاصة المسلمات، لديهن انقسام في الهوية بسبب الهيمنة والعنصرية في الثقافة المضيفة. ومع ذلك، فإنهن يحاولن سدّ هذا الانقسام من خلال رحلة استكشاف ثقافية تسمح لهن بالتصالح مع صورتهن الأولى في المرآة وفقًا لنظرية المرآة لدى لاكان.الكلمات المفاتيح: عرب، مسلمون، نساء، أمريكا، ازدواجية، لاكان***- Abstract: Evidently, the calamity of 9/11 has laid its weight on the writings of Arab American writers especially the Muslim ones (Harb, 2012). This study explores the subject of the integration of Arab and Muslim immigrants into the American society and its associated dilemmas post 9/11 from a psychological perspective. For that purpose, the study examines the duality in identity in Mohja Kahf’s novel: The Girl in the Tangerine Scarf through a Lacanian lens. A qualitative research methodology based on psychoanalysis is pursued in an attempt to reveal the cross- cultural crisis suffered by the female protagonist and the psychological repercussions that ensue from it. The analysis asserts that Arab females and especially Muslim ones seem to have a schism in identity due to hegemony and racism in their host culture. Yet, they try to bridge this division through a journey of cultural discovery which allows them to reconcile with their first mirror image as per Lacan’s Mirror Stage Theory.- Key words: Arab, Muslim, Women, America, Duality, Lacan**** ردينة وهيب فياض : تُعدّ أطروحة دكتوراه في الأدب الإنكليزي – المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية - الجامعة اللبنانية* Roudayna Wahib Fayad : Preparing a dissertation in English Literature at the Doctoral School of Literature, Humanities, and Social Sciences at the Lebanese University
مجلة الحداثة - صيف/خريف 2021 - عدد 217 /218 - Al Hadatha Journal
Published on October 24, 2021 08:15
•
Tags:
مجلة_الحداثة
La localisation des campagnes diffusées par les ONG

quels enjeux idéologiques?
♦ Sandy Georges Hallak *
- نبذة عن البحث باللغة العربية:توطين الحملات التي تشنّها المنظمات غير الحكومية أيّ تحدّيات ايديولوجيّة؟
يهدف البحث إلى معرفة كيف تترجم المنظمات غير الحكومية ولا سيّما المنظمات الإنسانية، النصوص والبيانات التي تبثّها على شبكات الإنترنت، فتعبر الحواجز وتتجاوز كل القيود اللغوية والثقافية، وتتغلغل ببراعة في العالم الثالث لترسيخ إيديولوجيّة معينة، أو أفكار محدّدة من خلال نشر كلمات قد لا تشير دائمًا إلى الواقع عينه. بمعنى آخر، كيف يضمن المترجم استدامة التواصل المتعدد الثقافات متخطّيًّا كل الحدود أو العوائق اللغوية والثقافية؟وتكمن أهميّة هذا البحث في كونه يعالج موضوعًا غيّر مهنة الترجمة وطريقة المترجم في أداء عمله، وما زالت الأبحاث النظرية المتعلّقة بالتوطين ضئيلة. علاوة على ذلك، إنّ الترجمة في كنف المنظمات غير الحكوميّة الإنسانية مقيّدة بعناصر ومعايير اقتصاديّة وإيديولوجيّة.الكلمات المفتاحية: حملات توعية، منظمات غير حكومية إنسانية، ترجمة، توطين، ثقافة***- Résumé: Cet article se propose de savoir comment les ONG et particulièrement, celles humanitaires traduisent les textes et les messages qu’elles diffusent sur leurs sites-web multilingues. Elles franchissent les barrières et pénètrent adroitement dans le tiers monde par-dessus toute contrainte linguistique et culturelle pour ancrer une certaine idéologie, certaines idées par le biais des mots qui ne renvoient pas toujours à une même réalité. En d’autres termes comment le traducteur garantit-il la pérennité de la communication multiculturelle par-dessus toute frontière linguistique et culturelle?Notre étude relève d’un sujet ardu à l’heure de la mondialisation et exploite un nouveau métier de la traduction qui exige du traducteur de nouvelles compétences et dont les recherches théoriques inhérentes sont peu nombreuses.- Mots-clés: campagne de sensibilisation - ONG humanitaires - traduction- localisation- culture***- ساندي جورج الحلاق : تعدّ أطروحة دكتوراه في علم الترجمة – المعهد العالي للدكتوراه – الجامعة اللبنانيةSandy Georges Hallak : a préparé une thèse intitulée «traduire pour sensibiliser: la traduction localisation des messages de sensibilisation» à l’Université Libanaise; École Doctorale des lettres et des sciences humaines et sociales sous la direction de Madame la Professeure Hoda Moukannas.*** مجلة الحداثة - صيف/خريف 2021 - عدد 217 /218 - Al Hadatha Journal
Published on October 24, 2021 07:46
La démarche Qualité dans les Laboratoires de biologie médicale au Liban Sa situation par rapport à la norme ISO 15189

♦ Rita Boutros Khattar *♦♦ Maha Elie Nehmé (MD) **
- نبذة عن البحث باللغة العربية:واقع الجودة في مختبرات التحاليل الطبية في لبنانوفاقًا لمعيار "ISO 15189"
يمثل معيار ISO 15189 متطلبات الجودة الخاصة بمجال البيولوجيا الطبية، وهو يشكل معيار الاعتماد المنظم أو الطوعي للعديد من مختبرات التحاليل الطبية في مختلف البلدان.من أجل تحديد موقع مختبرات التحاليل الطبية في لبنان في ما يتعلق بمعيار ISO 15189، أُجريت دراسة مقطعية متعددة المراكز بناءً على استبيان على عينة من 44 مختبرًا للتحاليل الطبية من مناطق جغرافية مختلفة من لبنان. وأظهرت النتائج وجود فجوة بين التنظيم والإشراف على أنشطة المختبرات الخاصة من جهة، وأنشطة المختبرات المدمجة في المستشفيات من جهة أخرى. ومع ذلك، سُلّط الضوء على الجهود التي تبذلها بعض المختبرات لمراقبة نهج الجودة، على الرغم من وجود عدد صغير من 10 مختبرات معتمدة في العينة. لوحظت انحرافات عن متطلبات الإدارة، بالإضافة إلى انحرافات أصغر عن المتطلبات الفنية للمعيار، كما تبين وجود ارتباط بين معايير معينة لهذه المتطلبات ونوع المختبر.الكلمات المفاتيح: معيار ISO 15189؛ الجودة؛ الاعتماد الأكاديمي؛ مختبر التحاليل الطبية؛ فرق؛ لبنان ***- Résumé: La norme ISO 15189 représente des exigences Qualité spécifiques au domaine de la biologie médicale. Elle constitue le référentiel d’accréditation réglementée ou volontaire de plusieurs laboratoires de biologie médicale dans divers pays.Dans le but de situer les laboratoires de biologie d’analyses médicales au Liban par rapport à la norme ISO 15189, une étude transversale multicentrique basée sur un questionnaire a été faite sur un échantillon de 44 laboratoires de biologie médicale répartis sur différentes zones géographiques du Liban. Les résultats ont montré un écart entre la réglementation et la surveillance des activités des laboratoires privés d’une part, et celles des laboratoires intégrés dans des hôpitaux d’autre part. Néanmoins, les efforts déployés par certains laboratoires pour le suivi d’une démarche Qualité sont mis en évidence, malgré un nombre restreint de 10 laboratoires accrédités dans l’échantillon. Des écarts par rapport aux exigences relatives à la gestion ont été notés, ainsi que des écarts moins importants par rapport aux exigences techniques de la norme. Une association entre certains critères de ces exigences et le type du laboratoire a aussi été démontrée.Mots-clés: qualité; accréditation; laboratoire de biologie médicale; norme ISO 15189; écart; Liban***- ريتا بطرس خطار : ماجستير في إدارة الصحة والمستشفيات- كلية الصحة - جامعة العائلة المقدسة - البترون- Rita Boutros Khattar: Master management de la santé et des hôpitaux – Faculté de Santé- Université Ste Famille- Batroun- مهى إيلي نعمة : طبيبة متخصصة أمراض داخلية- خبيرة ضمان الجودة – جامعة العائلة المقدسة- البترون- Maha Elie Nehmé (MD): Docteur en médecine interne- Expert Assurance Qualité- Université Sainte Famille - Batroun
مجلة الحداثة - صيف/خريف 2021 - عدد 217 /218 - Al Hadatha Journal
Published on October 24, 2021 07:24
مفهوم الأدب في كتاب "أدب الّطبيب" لإسحق بن عليّ الرُّهاويّ


♦ أليسار حسن إبراهيم *
- نبذة عن البحث:حَظِيَ مفهومُ الأدب بالكثيرِ من الدّراسات، وذلك لِمَا لهُ من أهميّةٍ تتجلّى في الدّلالات المتنوّعة الّتي اكتسبتها كلمة "أدب" عبر مساراتٍ زمنيّةٍ مختلفة. ونحن إنْ عدْنا إلى "لسان العرب" لابن منظور، نجد في مادّة "أَدَبَ" و"دأَبَ" عدّة كلمات مفاتيح، إذا التقطناها، نراها تندرجُ في إطارٍ قائمِ على الدّعوة إلى المحامد: "الأدبُ الّذي يتأدّبُ به الأديبُ من النّاس، لأنّه يأدبُ النّاسَ إلى المحامدِ"، كما نلحظُ دلالاتٍ أخرى كالتّعليم، والتّرويض، وحُسْن التّناول.
 إذا تَتَبّعنا كلمة "أدب" عبرَ العصور نجدُها قد تطوّرت لِتكتسبَ بُعدًا ثقافيًّا اتّسعَت درجةُ غِناه في العصر العبّاسيّ نتيجةَ الإحتكاك بالثّقافات الأخرى. من هنا ظهرتِ العديدُ من الكتب الّتي تتحدث عن آداب المهن.نعالج من خلال هذا البحث مفهومَ كلمة "أدب" في كتاب "أدب الطّبيب" لإسحق بن عليّ الرُّهاويّ (المتوفّى في الرّبع الأوّل من القرن الرّابع الهجري/العاشر؟) الطبيب الّذي عاش في العصر العبّاسيّ الثّاني، والعالم بكلام جالينوس. وقد اخترنا هذا الكتاب لندرسَ مفهوم كلمة "أدب" فيه، والدّلالاتِ التي اكتسبَتْها من خلال السّياق، ولنُبرِزَ مدى أهميّةِ وجودِ قواعد وضوابط لمهنة الطّبّ.فما هي درجةُ انتشار كلمة "أدب" في كتاب "أدب الطبيب"؟ وما هي المضامينُ والأبعاد التي اكتسبَتْها كلمة "أدب" من خلال هذا الكتاب؟في الواقع، إنّ الإجابة عن هذه الإشكاليّة تقتضي منّا اتّباعَ تنظيمٍ محدّدٍ، لذا استندْنا في دراستنا على منهجَين:- المنهج المعجميِ القائم على رصْدِ درجَةِ تواتر كلمة "أدب" في سياق نصّ الكاتب، والتقاطِ الدّلالاتِ المُتعلّقة بها (تأديب، دعوة إلى المحامد، ثقافة، عِلْم)، ثمّ العمل على تصنيفها في حقولٍ ذاتِ دلالاتٍ معّينةٍ (مِهَني، مَعْرفي، ديني، أخلاقي، سلوكي...)، معَ الإشارة إلى أنّ دراستَنا هي دراسةٌ داخليةٌ تحتاجُ إلى أن تُستَكمَل من حينٍ إلى آخرَ بدراسةٍ خارجيّة تحدّدُ البيئةَ والعصْر والمُناسَبة، والإطارَين الزّمانيّ والمكانيّ، لذا كان لا بدَّ من اعتماد المنهج التّاريخي أيضًا.وقد جعلْنا بحثَنا في ثلاثة أقسامٍ، عرّفْنا في القسم الأوّل بالرُّهاوي وآثاره، وقد بدأنا بهذا القسم لأنّه لا بُدَّ لقارىءِ البحثِ من أن يُحيطَ بالعصر الّذي نشأ فيه الرُّهاويّ، وبالأطبّاء الّذين قد تأثّر بهم، وأن يُدرِكَ مدى انفتاحِ العرب المسلمين في مجال الطّبّ على الحضارات الأخرى ولا سيّما اليونانيّة، ويتلمَّس مدى تأثير أخلاق الإسلام في المؤلّف الّذي ينتمي إلى الملّة اليهودّية، ثمّ ارتأينا أن نُدْرِجَ القسم الثّاني تحت عنوان: "الآداب والتّدابير في مهنة الطّب". وقد قدّمناه على القسم الثّالث لأنّنا اخترْنا أن ننطلقَ في بحثنا من الخاص إلى العام، أي من كلّ ما هو معرفي وأخلاقي خاص بالطّبيب وحده، كوْن عملية الإصلاح والتّعلّم تبدأ من الذّات، وتنطلقُ إلى الآخر. لذلك أورَدْنا في القسم الثّالث كل ما له علاقة بسلوكيّات الطبيب مع الآخر، سواء أكان هذا الآخر المجتمع بشكلٍ عام، أو المريض بشكل خاص، أو علاقة العوّاد بالمريض. محاولين تبيان مفهوم كلمة "أدب".أمّا بالنّسبة إلى المصادر والمراجع فقد اعتمدّنا على الكتُب الآتية:1- الرُّهاويّ، إسحق بن عليّ (الرُّبع الأوّل من القرن الرّابع الهجري/العاشر؟)، أدب الطبيب؛ حقّقه مريزن سعيد مريزن عسيري، ط1. الرّياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدّراسات الإسلاميّة 1412 ه/1992 م.هذا الكتاب هو مِحْورُ دراستنا، لذا استندْنا عليه في فهم حياة الرُّهاوي، وفي دراسة مفهوم كلمة "أدب" المنتشرة في بعض الأبواب.2- القفطي، علي بن يوسف بن إبراهيم (646ه/ 1249م)، إخبار العلماء بأخبار الحكماء؛ حقّقه إبراهيم شمس الدّين، بيروت: دار الكتب العلميّة 2005 م.مَن يتطرّق لدراسةِ حياة الرُّهاويّ، يلحظ عدمَ وجودِ تحديدٍ دقيقٍ لتاريخ الولادة والوفاة، لذا كان لا بُدَّ من رصْدِ أسماء بعض الأطباء الّذين عاصروه لفترات زمنيّة معيّنة، أو تأثّر بهم، وقد أفادنا كتاب القفطي في هذا المجال، إذْ اطّلَعْنا من خلاله على ترجمةٍ لبعض الأطبّاء.3- ابن أبي أصيبعة، أحمد بن القاسم بن خليفة (668ه/1312م) عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء، تحقيق نزار رضا، بيروت: دار مكتبة الحياة، 1965م. أفادنا هذا الكتاب في القسم المتعلّق بالتّرجمة الدّقيقة للرُّهاوي.4- ضيف (شوقي)، تاريخ الأدب العربيّ: العصر العبّاسي الثّاني، ط.2، القاهرة: دار المعارف بمصر، 1973.اطْلعّنا من خلال هذا الكتاب على الحقبة التّاريخيّة الّتي عاش فيها الرُّهاوي، كتحوّل مقاليد الحكم إلى الأتراك، وحدوث ثورة الزّنج، وانطلاق حركة التّرجمة. **** تعدّ أطروحة دكتوراه في اللغة العربية وآدابها - جامعة القديس يوسف - بيروت***
مجلة الحداثة - صيف/خريف 2021 - عدد 217 /218 - Al Hadatha Journal
إذا تَتَبّعنا كلمة "أدب" عبرَ العصور نجدُها قد تطوّرت لِتكتسبَ بُعدًا ثقافيًّا اتّسعَت درجةُ غِناه في العصر العبّاسيّ نتيجةَ الإحتكاك بالثّقافات الأخرى. من هنا ظهرتِ العديدُ من الكتب الّتي تتحدث عن آداب المهن.نعالج من خلال هذا البحث مفهومَ كلمة "أدب" في كتاب "أدب الطّبيب" لإسحق بن عليّ الرُّهاويّ (المتوفّى في الرّبع الأوّل من القرن الرّابع الهجري/العاشر؟) الطبيب الّذي عاش في العصر العبّاسيّ الثّاني، والعالم بكلام جالينوس. وقد اخترنا هذا الكتاب لندرسَ مفهوم كلمة "أدب" فيه، والدّلالاتِ التي اكتسبَتْها من خلال السّياق، ولنُبرِزَ مدى أهميّةِ وجودِ قواعد وضوابط لمهنة الطّبّ.فما هي درجةُ انتشار كلمة "أدب" في كتاب "أدب الطبيب"؟ وما هي المضامينُ والأبعاد التي اكتسبَتْها كلمة "أدب" من خلال هذا الكتاب؟في الواقع، إنّ الإجابة عن هذه الإشكاليّة تقتضي منّا اتّباعَ تنظيمٍ محدّدٍ، لذا استندْنا في دراستنا على منهجَين:- المنهج المعجميِ القائم على رصْدِ درجَةِ تواتر كلمة "أدب" في سياق نصّ الكاتب، والتقاطِ الدّلالاتِ المُتعلّقة بها (تأديب، دعوة إلى المحامد، ثقافة، عِلْم)، ثمّ العمل على تصنيفها في حقولٍ ذاتِ دلالاتٍ معّينةٍ (مِهَني، مَعْرفي، ديني، أخلاقي، سلوكي...)، معَ الإشارة إلى أنّ دراستَنا هي دراسةٌ داخليةٌ تحتاجُ إلى أن تُستَكمَل من حينٍ إلى آخرَ بدراسةٍ خارجيّة تحدّدُ البيئةَ والعصْر والمُناسَبة، والإطارَين الزّمانيّ والمكانيّ، لذا كان لا بدَّ من اعتماد المنهج التّاريخي أيضًا.وقد جعلْنا بحثَنا في ثلاثة أقسامٍ، عرّفْنا في القسم الأوّل بالرُّهاوي وآثاره، وقد بدأنا بهذا القسم لأنّه لا بُدَّ لقارىءِ البحثِ من أن يُحيطَ بالعصر الّذي نشأ فيه الرُّهاويّ، وبالأطبّاء الّذين قد تأثّر بهم، وأن يُدرِكَ مدى انفتاحِ العرب المسلمين في مجال الطّبّ على الحضارات الأخرى ولا سيّما اليونانيّة، ويتلمَّس مدى تأثير أخلاق الإسلام في المؤلّف الّذي ينتمي إلى الملّة اليهودّية، ثمّ ارتأينا أن نُدْرِجَ القسم الثّاني تحت عنوان: "الآداب والتّدابير في مهنة الطّب". وقد قدّمناه على القسم الثّالث لأنّنا اخترْنا أن ننطلقَ في بحثنا من الخاص إلى العام، أي من كلّ ما هو معرفي وأخلاقي خاص بالطّبيب وحده، كوْن عملية الإصلاح والتّعلّم تبدأ من الذّات، وتنطلقُ إلى الآخر. لذلك أورَدْنا في القسم الثّالث كل ما له علاقة بسلوكيّات الطبيب مع الآخر، سواء أكان هذا الآخر المجتمع بشكلٍ عام، أو المريض بشكل خاص، أو علاقة العوّاد بالمريض. محاولين تبيان مفهوم كلمة "أدب".أمّا بالنّسبة إلى المصادر والمراجع فقد اعتمدّنا على الكتُب الآتية:1- الرُّهاويّ، إسحق بن عليّ (الرُّبع الأوّل من القرن الرّابع الهجري/العاشر؟)، أدب الطبيب؛ حقّقه مريزن سعيد مريزن عسيري، ط1. الرّياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدّراسات الإسلاميّة 1412 ه/1992 م.هذا الكتاب هو مِحْورُ دراستنا، لذا استندْنا عليه في فهم حياة الرُّهاوي، وفي دراسة مفهوم كلمة "أدب" المنتشرة في بعض الأبواب.2- القفطي، علي بن يوسف بن إبراهيم (646ه/ 1249م)، إخبار العلماء بأخبار الحكماء؛ حقّقه إبراهيم شمس الدّين، بيروت: دار الكتب العلميّة 2005 م.مَن يتطرّق لدراسةِ حياة الرُّهاويّ، يلحظ عدمَ وجودِ تحديدٍ دقيقٍ لتاريخ الولادة والوفاة، لذا كان لا بُدَّ من رصْدِ أسماء بعض الأطباء الّذين عاصروه لفترات زمنيّة معيّنة، أو تأثّر بهم، وقد أفادنا كتاب القفطي في هذا المجال، إذْ اطّلَعْنا من خلاله على ترجمةٍ لبعض الأطبّاء.3- ابن أبي أصيبعة، أحمد بن القاسم بن خليفة (668ه/1312م) عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء، تحقيق نزار رضا، بيروت: دار مكتبة الحياة، 1965م. أفادنا هذا الكتاب في القسم المتعلّق بالتّرجمة الدّقيقة للرُّهاوي.4- ضيف (شوقي)، تاريخ الأدب العربيّ: العصر العبّاسي الثّاني، ط.2، القاهرة: دار المعارف بمصر، 1973.اطْلعّنا من خلال هذا الكتاب على الحقبة التّاريخيّة الّتي عاش فيها الرُّهاوي، كتحوّل مقاليد الحكم إلى الأتراك، وحدوث ثورة الزّنج، وانطلاق حركة التّرجمة. **** تعدّ أطروحة دكتوراه في اللغة العربية وآدابها - جامعة القديس يوسف - بيروت***
مجلة الحداثة - صيف/خريف 2021 - عدد 217 /218 - Al Hadatha Journal
Published on October 24, 2021 06:31
•
Tags:
مجلة_الحداثة
October 21, 2021
حسن حنفي وداعًا : انتصر الموت ولم تنهزم الحياة


رسم المفكر المصري حسن حنفي (1935 – 2021) عبر ترجماته لعشرات الفلاسفة، ومؤلفاته الفلسفية، صورة مغايرة للإسلام التقليدي. مثّل جيلًا له موقعه ورؤيته للتاريخ الفلسفي. كان مجتهدًا، واجه السلفية الإسلامية النمطية التي شوّهت صورة الإسلام وساهمت في تغليب ثقافة الموت على ثقافة الحياة.
حنفي نودّعه ونحن التلامذة الذين سنكمل ما بدأه المصلح الكبير، فقد ساهم إلى جانب مفكرين عرب: محمد أركون ومحمد عابد الجابري وعبدالله العروي وناصيف نصار والياس مرقص وياسين الحافظ وعبدالله العلايلي وفاطمه المرنيسي ونوال السعداوي وغيرهم، في إثراء الفكر الفلسفي العربي.
أذكر في أحد اللقاءات بين د. علي مبروك ود. حنفي تلك التى كان لكل منهما رأيه في النظرة إلى التيارات الإسلامية وممارستها، لم يبتعد مبروك من خصوصيات التطور التاريخي للمجتمع المصري، مستشهدًا بأطروحات سمير أمين وأحمد صادق سعد ونيللي حنا. وأذكر كذلك، أنني دعيت لحضور مناقشة أطروحة دكتوراه للطالبة ماجدة يوسف عن فكر هيغل بإشرافه ومشاركة د. زينب الخضيري، وقد دار نقاش حول المنهجية الأكاديمية في الإشراف على العمل الأكاديمي المقدم من طلاب الدكتوراه، ورأت الخضيري أن في كتابات حنفي خروجًا على علم السياسة إلى العلم اللاهوتي، وبهذا لم يعد هناك من سياسة، بل أصبحنا فى معركة عقائدية.
ومن محاضراته أيضًا، محاضرة ألقاها في المكتبة الوطنية الجزائرية في العام 2007، وقد أثارت زوبعة من النقاش، إذ دعا فيها إلى تأسيس تيارات فكرية يسارية إسلامية تحت حجج من واقعية أيديولوجية.
وأذكر أيضًا، أنني دعيت منذ سنوات لتكريم حنفي في بيت السفارة العراقية في مصر، وكان الداعي د. قيس العزاوي السفير والممثل للجمهورية العراقية في جامعة الدول العربية. في هذا اللقاء، أعاد د. جابر عصفور إلى الذاكرة يوم ذهب حنفي لخطبة حبيبته التي أصبحت في ما بعد زوجته، وذكر أن حنفي كان يخبئ تحت جاكيته دجاجة، وعندما تمت الخطبة، أظهر الدجاجة، وكان عشاء يتذكره جميع من حضروا الخطبة.
رحم الله العلامة حسن حنفي الذي ترك بصمة في الفكر الفلسفي لن تنسى. سيفتقدك تلامذتك، وستبقى في الذاكرة مدماكًا شامخًا من مداميك الفكر الفلسفي.
لروحك السلام.
***
* رئيس التحرير
Published on October 21, 2021 03:29
•
Tags:
مجلة_الحداثة
August 30, 2021
مجلة الحداثة: واقع الهجرة والتباعد والتشظي المديني والعدالة الاجتماعية - ربيع 2021

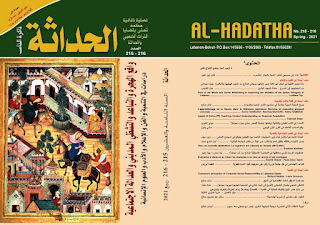
صدر العدد الجديد من مجلة الحداثة - al hadatha journal – فصلية ثقافية أكاديمية محكمة (ربيع 2021 – عدد 215 - 216) تحت عنوان:
"واقع الهجرة والتباعد والتشظي المديني والعدالة الاجتماعية -
دراسات في التنمية والفن والإعلام والأدب والعلوم الإنسانية"
وضم عدد الربيع 2021 من المجلة التي تصدر بترخيص من وزارة الإعلام اللبنانية (230 ت 21/9/1993) ويرأس تحريرها فرحان صالح، عددًا من الملفات والأبحاث الأكاديمية، واستهل بافتتاحية تحت عنوان: نداء إلى مسرحيي العالم: اهدموا "الجدار الخامس لهشام زين الدين.
ومن الملفات التي ضمّها العدد: أبحاث في الفنون والإعلام، وشمل الأبحاث: سنة ترامب الأخيرة في الحكم عبر ثلاث صور (تحليل سيميائي لنماذج من "أرض اليوتوبيا والأحلام") لحوراء حوماني، ومن الميتولوجيا إلى المسرح - معاناة الوجود البشريّ لجان القسّيس، وRole of the Media and Social Networking in improving the situation of the Syrian Refugees in Lebanon - Loubane Tay.
وضم ملف: أبحاث في اللغة والأدب والترجمة، عددًا من الدراسات منها: جروح المخيلة العربية (مقاربة في مضامين الشعر الحديث وقضاياه) لكامل فرحان صالح، وL’apprentissage de la femme dans la littérature algérienne féminine et masculine pré/post coloniale - Amina TAHRAOUI- Rachida SADOUNI- Fatiha RAMDANI، وImpact of Online EFL Teaching: Content Understanding vs. Grammar Acquisition - Fatemah Bazzi، والأسماء في الأدب الخيالي وإشكالية ترجمتها (سلسلة قصص "هاري بوتر" نموذجًا) لميراي الخوري، وواقع أصحاب العاهات في القرن الأول الهجري لسامي جلول.
أما ملف: أبحاث في العلوم الاجتماعية والنفسية، فضم: العدالة الاجتماعية والأسرُ أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة بين القوانين والواقع في المجتمع اللبناني لتريز سيف، وإدمان الانترنت وعلاقته بالقلق العام والاكتئاب لدى عينة من طلاب الجامعة اللبنانية لنبال الحاج محمد، وVers une nouvelle destination: La migration des Libanais en Turquie (2019-2021) - Suzanne Menhem ، وLes immigrants au Liban: droits, devoirs et politiques étatiques - Ola Al Kontar، واضطرابات الوسط الأسري وعلاقتها في الشخصية الانحرافية (نماذج من أسر لبنانية) للينا نحاس وجينا زعيتر، وÉvaluation à distance au Liban: les obstacles à sa mise en œuvre et ses avantages - Ziad Al Otayek - Paula Abou Tayeh، والتباعد الاجتماعي في ظل جائحة كورونا وأثره على سلوكيات أفراد الأسرة القطرية لفاطمة أبوراس.
وشمل ملف: أبحاث في التنمية، الموضوعات: Customers’ perception of Corporate Social Responsibility in Lebanese Banks - Richard Sadaka - Layla Tannoury، وخصخصة المرافق العامة الاقتصادية في العراق لسنان صالح، والتشظي المديني والسكن العشوائي (النزوح إلى الرمل العالي في الضاحية الجنوبية لبيروت نموذجًا) لعماد مقداد، ودور إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانيّة في التنمية - اقتصاديًّا واجتماعيًّا ودعم الخزينة والبلديات والمزارعين لميلو الغصين ومارينا صبّوري الخيّاط ، والعقود: ترف حضاري أم ضرورة اجتماعية؟ لسنان عبد الحسين صالح.
أخيرًا، قدم رئيس التحرير فرحان صالح في باب "نوافذ" قراءة في: تجربة الاكتفاء الذاتي الناصرية مرجعية لمواجهة التغريب (حوار مع صديقي سعد محيو).
يشار إلى أن العدد الأول من المجلة صدر في بيروت في العام 1994.

مجلة الحداثة
facebook - twitter - goodreads - instagram - linkedin
(للمزيد: المعرّفات)
صفحة الويب - صفحة الجوال
Published on August 30, 2021 08:24
•
Tags:
مجلة_الحداثة
مجلة الحداثة - Al Hadatha Journal
Al Hadatha Journal - A Refereed Academic Quarterly
مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة
تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)
ISSN/2790 Al Hadatha Journal - A Refereed Academic Quarterly
مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة
تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)
ISSN/2790-1785
تُعنى المجلة بنشر الأبحاث الأكاديمية بعد عرضها على لجنة علمية متخصصة. وتبلورت فكرة نشوء المجلة بعد اجتماعات عمل متواصلة بين رئيس تحريرها فرحان صالح وأصدقاء باحثين وأكاديميين من لبنان والعالم العربي، وقد بات عدد منهم ضمن الهيئة الاستشارية للمجلة، علمًا أن بعضهم قد فارق الحياة، وقد جرى إضافة أسماء إلى الهيئة لاحقًا. تغطي مجلة الحداثة الأبحاث التي تأتي من شريحة واسعة من الأكاديميين والمفكرين والكتّاب والأدباء في لبنان والعالم العربي، فتنشر موضوعات تتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والسياسية، كذلك، موضوعات تتعلق بقضايا فكرية وتراثية وأدبية ونقدية وفنية وإعلامية ...more
مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة
تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)
ISSN/2790 Al Hadatha Journal - A Refereed Academic Quarterly
مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة
تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)
ISSN/2790-1785
تُعنى المجلة بنشر الأبحاث الأكاديمية بعد عرضها على لجنة علمية متخصصة. وتبلورت فكرة نشوء المجلة بعد اجتماعات عمل متواصلة بين رئيس تحريرها فرحان صالح وأصدقاء باحثين وأكاديميين من لبنان والعالم العربي، وقد بات عدد منهم ضمن الهيئة الاستشارية للمجلة، علمًا أن بعضهم قد فارق الحياة، وقد جرى إضافة أسماء إلى الهيئة لاحقًا. تغطي مجلة الحداثة الأبحاث التي تأتي من شريحة واسعة من الأكاديميين والمفكرين والكتّاب والأدباء في لبنان والعالم العربي، فتنشر موضوعات تتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والسياسية، كذلك، موضوعات تتعلق بقضايا فكرية وتراثية وأدبية ونقدية وفنية وإعلامية ...more
- مجلة الحداثة's profile
- 11 followers



