عبـــــــدالله خلــــــــيفة's Blog: https://isaalbuflasablog.wordpress.com , page 43
April 23, 2023
الوعي والمادة
جسد فهم المجتمعات للمادة، وهي الأشياء والعالم الخارجي الموضوعي، خارج العقل البشري، مدى قدرة البشر على السيطرة على الطبيعة والمجتمع، ومدى قدرتهم على التصنيع وخلق تراكم للعلوم الطبيعية والاجتماعية.
وقد بدأ العرب يقاربون الحضارة الحديثة منذ أن تفتحت عيون المثقفين في النهضة الحديثة، ومن ثم راحوا يراكمون وعياً جديداً مختلفاً عن (المادة) منذ الأنظمة الملكية الليبرالية فالأنظمة العسكرية الوطنية والثقافة التنويرية العلمانية وراح يتصاعد بتقطع وضعف دون أن قطع بجذورهم الإسلامية والقديمة والإنسانية.
وهذا التصاعد والتقطع والاستمرارية تعبر كلها عن حصيلة الصناعة والعلوم والحرية وعن جذور ضعيفة في حفر الأرض المادية.
لقد كان الحصول على معنى المادة ومعنى العلم وكشف سببيات الوجود لتلك القبائل التي خرجت من الجزيرة العربية أمراً صعباً محفوفاً بالمخاطر ولجماعاتٍ أميةٍ محدودة الأرث العلمي، والتي إنتجت منها فئات وسطى حرفية وثقافية في ظل الإمبراطورية وراحت تتساءلُ عن معنى الوجود وكيفية فهمه وكيف السيطرة عليه؟
إن الشعوبَ لا تفهم الطبيعةَ والمجتمعَ بشكلٍ مجرد سحري غيبي تلقائي عجائبي بشكلٍ أساسي، وإن كانت هذه هي المراحلُ الدنيا لتشكلِ العقول، لكنها تتجاوزها، لأنها ذات مستويات دنيا، ولاعتمادها على الحدس وهو أدنى أشكالِ الفكر وعلى التجارب البسيطة غير المعللة وغير المجربة تجريباً حديثاً.
لكن هذه الأشكال الدنيا ملاصقة كثيراً للعرب والمسلمين لأنهم في المستويات الدنيا من الإنتاجين الصناعي والعلمي، ومن هنا فالأشكال الأخرى من السحر والدين غير العقلاني تبقى مترافقةً مع هذا التطور ذي المستوى المنخفض.
ومن هنا كانت الجهود الجبارة للعلماء العرب والمسلمين في إنتزاع أسرار الطبيعة والمجتمع، وهم في بدايات الحضارة، وهو أمر مهدهُ علماءُ اللغةِ والكلامِ ثم الفلاسفة، الذين وضعوا جميعاً القواعدَ الأولى لبناءِ العقلية العربية الموضوعية النقدية، التي تراكمُ لبناتِ المعرفةِ الموثَّقة، والتي تكشفُ خلايا المادةِ وعملياتِ التغلغلِ فيها بشتى أشكالِ تمظهراتها، سواءً كانت جسم إنسان أو حيوان أو أشياء مادية بمختلف حالاتها، أو كانت كوكباً أم نجماً.
ولا تنفصلُ العلومُ الإنسانيةُ هنا عن العلوم الطبيعية، بل كانت هي مقدمتها، فتطورُ علومِ النحو والصرف والبيان ودراسة جذور اللغة وحياة العرب الاجتماعية، قادَ إلى وضعِ لغةٍ كبيرة ذات إمكانيات تعبيرية وإشتقاقية حيوية تحت تصرف علماء الطبيعة والرياضيات والطب والفلك والكيمياء وغيرهم.
فتغيرت الرياضيات بداية من تغيير الأرقام إلى جعل الصفر فيها وجعلها بالتالي سهلة ولا نهائية الحساب، لأن المادة لانهائية، وعبر الجبر تم إظهار الكم المجهول من الكم المعلوم، فغدت الرياضيات أداةً أخرى، وتطورت الهندسة الأقليدية، خاصة عبر التلاقح مع الثقافة اليونانية، ثم بدأت الكيمياء والفيزياء بالتطور مع تطور الحرف والصناعات.
لكن هل تنفصل العلوم هنا عن الشعوذة خاصة مع هذه النشأة الأولى الضعيفة؟
(أخذ جابرٌ«بن حيان» مادة الكيمياء – كما هو معلومٌ – من مدرسةِ الإسكندرية التي كانت تقولُ بإمكانيةِ انقلابِ العناصر وتحولها بعضها إلى بعض، وأخذ مع هذه الكيمياء فيضاً من الفلسفة الهيلينية والآدابَ السحريةَ والتصوف والروحية الإيرانية)، (الجامع في تاريخ العلوم عند العرب، الدكتور محمد عبدالرحمن مرحبا، منشورات عويدات ط2، 1988، ص 315).
إن إمكانياتِ الوصولِ إلى الأبعادِ المتعددة للمادةِ مسألةٌ مرهونةٌ بقوى الإنتاجِ السائدة في المجتمع وتجلياتها في البحثِ العلمي خاصةً مدى تقدم الحرف ومن ثم وجود معامل الإختبار، وظهور وتعمق تخصصات العلماء، وتنوع أدوات السبر والصهر والتحليل المختلفة.
ولهذا فإن حدوثَ جدلٍ عميقٍ بين الصناعة والعلوم لم يحدث:
(مزجَ العلماء العرب والمسلمون الذهبَ بالفضة، وإستخدموا القصديرَ لمنع التأكسد والصدأ في الأواني النحاسية، وإستخدموا خبرتَهم الكيمائية في صناعةِ العطور ومواد التجميل وصناعة الأقمشة والشموع..) الخ، الموسوعة العربية العالمية، ص 460.
لنلاحظ هنا كيف أن منهجيات البحث العقلي كانت محدودة وكذلك فإن توجه الطبقات الحاكمة للاستئثارِ بجانبٍ كبيرٍ من الفيضِ الإقتصادي، وجهَ الصناعات نحو الصناعات الاستهلاكية التابعة للقصور وكبارالتجار، مثلما أن الحركة الفلسفية لم تقمْ بتحليلات عميقة للمواد الطبيعية والاجتماعية.
إن المادة هنا باعتبارها مواداً وكواكب ونجوماً، أي مادةً كونيةً، لم تتغلغلْ الأبحاثُ فيها، فجثمت أشكالُ الوعي العربي العلمية على سطوح المواد والعمليات، وهي الموادُ المقاربةُ للاستهلاكِ أو للصحةِ الجسدية البسيطة، أو للتنجيم، وهو الثقبُ الأسودُ الذي إنهالتْ فيهِ موادُ الخرافةِ الواسعة وبلعتْ العقولَ والحضارة العربية.
وحتى شبكة العلوم الطبيعية كانت خاضعةً لأهدافِ الطبقاتِ العليا، فالطبُ والتنجيمُ والصيدلةُ يتمُ الصرفُ عليها، في حين لا تحظى علومٌ أخرى بمثل ذلك.
إن أشكال الوعي من دين وفلسفة وعلوم لم تستطع أن تصل إلى المادة إلا بمستويات محدودة وعجزتْ عن كشفِ تنوعاتِها والوصولِ إلى مكوناتِها الأصغر، وفي مختلفِ تجليات المادة الحية والجامدة على السواء، كما لم تصلْ – تلك الأشكال- إلى فهم عمليات المادة الأكثر تطوراً وهي الحياة الاجتماعية البشرية ونتاجها الأعمق وهو الظاهرات الفكرية.
ومن هنا فقدتْ مفاتيحَ إستمرار النهضة والتقدم وتوقفت وتخلفت.
إن أحجامَ إكتشاف المادة في الحضارتين الكبريين الإغريقية والعربية والحضارات الأخرى كذلك مثل الصينية والهندية، لم تصل إلا لكشف سطوح المادة، لكن في الحضارة الغربية التي تصاعدت منذ القرن الخامس عشر بدأت ظروف جديدة تتشكل، فقد أزيلت الدولة الكلية الإستبدادية وأُبعدت أحجارُ سيطرتِها وهي الأديان الكاتمة على حريات العقول وإنفتح المجال للتجريب العلمي الحر.
لكن ذلك إستغرق زمناً طويلاً وبتفاعل البُنى الاقتصادية والفكرية لكل المجموع النهضوي الغربي، بحيث تمَ تجاوزُ الحرفةَ، بظهورِ الصناعتين اليدوية فالآلية، والأخيرة هي الذروة ولأول مرة في التاريخ، وبهذا فإن المادة بمختلف تجلياتها الكونية والأرضية وُضعت تحت أصابع وعيون البشر لتفحصها، بشكلٍ تاريخي متدرجٍ يعكسُ تطورَ الصاعاتِ والملاحةِ وسيطرتهم على الأشياء والمنتجات والخريطة الأرضية.
إن الأجسامَ الفضائية كالكواكب والنجوم أُعيد النظر إليها، ورئُيتْ حركةُ الأجسام الكوكبية بشكلٍ صحيح، فبدأت المناظير تتجه إلى المواد الأصغر فالأصغر، دون أن يتوقف تحليل المواد الكبرى.
وهذه المراحلُ الأولى من الإكتشافاتِ الجغرافية والصناعة أعطتْ إقتراباً من الأجسامِ الفلكية الكبرى وساهمَ ذلك في إستعادةِ وحدةِ الكرة الأرضية، وبتواضعِ الأرض في المجموعة الشمسية لكنها صارت أقوى، ودخلتْ في تشكيلةٍ تاريخية جديدة هي الرأسمالية جعلتْ المادةَ البضائعية هي محور الاقتصاد والمعامل.
أعطت هذه المرحلة تغلغلات كبيرة في المواد الصناعية، فتمكن تشارلس داروين من فهم سببيات تطور الأحياء، وكشف كارل ماركس مادة البضاعة وتناقضاتها الاجتماعية، وهو مستوى لا يعود للبيولوجيا بل للعلوم الإنسانية، وتغلغل فرويد في فهم مادة العقل وطبقاته في الوعي واللاوعي إضافة لعلماء آخرين كشفوا جوانب أخرى من هذه المادة المُـفَّكرة، وهذه كانت ذروة العلوم في القرن التاسع عشر والثلث الأول من القرن العشرين.
في القرن العشرين تعرت المادة تعرية واسعة جداً، إتسع الكون إتساعاً عظيماً، ورُئي كمجراتٍ تشكلتْ في الانفجار العظيم، وهو الكون المرئي التاريخي لنا، أي كوننا، لأنه من الممكن أن تكون هناك أكوان أخرى، وكذلك فإن مادة هذا الكون دُرست وحُللت.
(المادة في الفيزياء الكلاسيكية هي كل ما له كتلة وحجم ويشغل حيزاً من الفراغ)، الموسوعة. لكن هذا هو الشكل الكلاسيكي للمادة فقد تداخلت المادة والطاقة، صارتا نوعاً واحد بوجهين.
وكما أن المادة لانهائية في الكبر فهي لا نهائية في الصغر، والحديث عن وجود حدود لها هو مجرد ظن:
(تتكون المادة من جسيماتٍ بالغة الصغر تسمى الجزيئات، وهي عبارة عن تجمعات لجسيمات أصغر هي الذرات. وتلك بدورها تتكون من جسيمات أصغر. ويُعتقد حالياً أن المادة تتكون من أجسام صغيرة جداً لا تتجزأ، حيث أنها لا تتكون من جسيمات أصغر بل هي أصغر شيء. وتـُسمى هذه الجسيمات بـ”الجسيمات الأولية”، ومع هذا فليس من المُثبت بعد أنها فعلاً أصغر الأجسام المكوّنة للمادة.)، موسوعة
كشفتْ المادةُ عن كونِها حركةً صراعية، فأجزاء الذرة الداخلية متضادة، دائبة الحركة، والمادة الطبيعية الكونية في صراع دائم بين مكوناتها وفي العلاقات بينها، وهي في حالة سيولة دائمة من الحركة.
المادة هي جزء من كوننا، ولا يُمكن إطلاق هذا المطلح على ما وراءه. ويُعتقد حالياً أن المادة تـُشكل 27% من كلتة الكون، 4% فقط هي المادة الطبيعية، والتي تنقسم إلى نوعين رئيسيّين: مادة مضيئة وغير مضيئة، وتــُشكل الأولى 0.4% من كتلة الكون، في حين أن الثانية تـُشكل 3.6% من كتله. أما الـ23% الأخرى فهي المادة المظلمة، والـ73% الباقية هي الطاقة المعتمة.
ليست قدرات العلوم الغربية وإمكانيات الثورة التقنية التي عصفت بالقرن العشرين هي مجرد إهرامات من الأفكار المجردة بل هي تحولات كبيرة في العلاقات الدولية قادت إلى إنقلاب أوضاع الدول وتأكيد الغرب لقيادته للمسيرة العالمية تبعاً لمصالحه ومن خلال موقعه المتميز، وبالعصف بنظم ماقبل الراسمالية والرأسماليات الحكومية الشرقية.
لقد برز صراع العلوم والثورة المعلوماتية والتقنيات الغربية في مواجهة وأمية العالم الثالث وتخلفه الثقافي ومحدوديته العلمية وتبلور في كونهِ صراعَ أساليب إنتاج وثروات تنتقل من جهة الشرق لجهة الغرب، فقد بلغ نسبة إنتاج العالم النامي 7% من الإنتاج الصناعي العالم، وبلغ حجم ديونه 2 تريليون دولار، رغم ضم هذا العالم النامي 70% من سكان العالم.
إن مجموع الارباح التى حولتها الاستثمارات الغربية لبلادها قد بلغ 139,7 بليون دولار خلال عقد 1970 – 1980.
فليست الثورة العلمية والتقنية هي مجرد أفكار مجردة، وليست هيمنة العلوم على المواد، هي أشكال ثقافية، بل سيطرة على المواد الخام، والاستثمارات والثروة المعرفية الجديدة.
إن عجز العالم النامي، ومنه العالم العربي، هو في أبنيته الاجتماعية – الثقافية المتخلفة، فعقلنة العالم وقراءاته السببية والقانونية، تترافق مع تغيير العلاقات بين الثقافة والتربية والتعليم وبين الإنتاج، مع تغيير الهياكل الاجتماعية الذكورية، مع تغيير الهياكل الحكومية البيروقراطية، مع الإنتقال للديمقراطية.
إن الثورة العلمية والتقنية الغربية تتغلغل كذلك في تغيير المواد التي ينتجها العالم النامي كذلك، فهي تطيح باقتصاده التقليدي كذلك:
(ومن الأمثلة على الصناعات التى قامت على الهندسة الوراثية (التكنولوجية الحيوية) والتى تم بها ايجاد منتجات تحل محل الانتاج الزراعي في العالم المتخلف التوصل الى انتاج النيلة(منتج صناعي يُستخدم في الصباغة) التى تنتجها الهند، وانتاج خيوط مخلقة لتحل محل السيزاك والمطاط، وانتاج حبوب الفانيليا بدلا من الطبيعية التى تنتجها مدغشقر وإنتاج حوالى ثلاثين بديلاً للصمغ العربي الذي ينتجه السودان)،(تاج السر.
إذا قرأنا هذه التحولات العاصفة الغربية وإنعكاساتها على المستوى الفكري، وربطنا بين إنهيار العقلانية العربية بعد ابن رشد، وعجز القوى الفكرية المختلفة عن العودة حتى إلى هذه العقلانية الفلسفية الدينية المثالية، فسوف نرى إنهيار المجتمعات العربية وعجزها عن الارتفاع لتحديات العلوم الغربية وثورتها المشار إليها، فغياب العقلانية الفلسفية يشير إلى عجوزات مختلفة؛ عدم القدرة على نشر التصنيع وخلق قوى عاملة متقدمة ماهرة تقنياً، وضعف وعي النساء وحضورهن التقني والعلمي، وهيمنة الثقافة السحرية على الوعي العام الخ.
أي أن الحضور العربي الراهن هو بسبب إنتاج المواد الخام الثمينة وأهمها البترول، الذي يجعل العديد من الدول العربية لا تعلن أفلاسها وإنهيارها الاقتصادي، ولما سببه البترول من حراك إقتصادي شمل دولاً عربية عديدة كذلك.
وقيام الاقتصاديات والأبنية الاجتماعية العربية على إقتصاد نفطي يؤكد غياب العرب عن ثقافة العالم المعاصر العلمية، وتشكل هذا العالم على الوعي غير العلمي.
فليس الوعي بالمادة كرؤية فلسفية مسألة تجريدية، بل تتعلق بصميم التطور البشري، فحين يرفض أبوحامد الغزالي السببية في زمن الثقافة العباسية، ولا تدخل هذه كرؤية شاملة في مختلف تجليات الظاهرات الطبيعية والاجتماعية، وأن لا تزال هذه الرؤية سائدة في الثقافة العامة، فهذا يظهر الفرق بين ثقافة غربية أحتوت عالم المواد وصنعتها كذلك وبين ثقافة لا تزال تعيش على الحرف وإنتاج المواد الخام.
لقد غدت هذه الثقافة الغربية التقنية تدخل إلى نسيج المواد وتغير تركيبها الطبيعي، وقد أمكنها صناعة الخلية الحية والقيام بالاستنساخ.
ظهور المادية الجدلية
لم يكن لدى الفلسفات الغربية وهي تخرج من العصر الوسيط الديني المسيحي سوى الاعتماد على فلسفة أرسطو مادةً ومنهجا، وكانت التطورات الصناعية والتحولات المختلفة تدفع العلوم نحو استيعاب مختلف للحركة، وقد قام ديكارت ونيوتن بطرح مفهوم جديد للحركة هو الفلسفة الميكانيكية، وقد رأينا الفلسفة العربية الإسلامية السابقة وهي تستعين بمنهج أرسطو ذاته ورؤيته لفهم الحركة فكان أقصى جهد لها هو فهم حركة الأجسام في المكان.
ولكن الأدوات والمعلومات التي توفرت في العصر الأوروبي الجديد، التي قام بها غاليلو وكوبرنيكس وغيرهما من العلماء أتاحت فهم حركة الكواكب والشمس بطريقة مختلفة عن السائد في العصر القديم، مما جعل ميكانيكا فهم الأجسام الكبيرة تسيطر على الوعي العام بالحركة. وقد تمظهرت هذه لدى نيوتن بقوانين الجاذبية. وحددت هذه الفلسفة ميكانيكا الأجسام عموماً حيث الحركة في المكان- الزمان تقوم على قوانين مادية محضة، أي قوانين من داخل المادة، ولكن الداخل هنا بمعنى حركة الأشياء، فظل التناقض المادي الجسمي الخارجي الآلي هو المسيطر على فهم هذه الحركة الأبدية العامة، لكن كان لا بد من وجود مصدر لظهور هذه الحركة فكان الإله. وهنا تتآلف الفلسفة الميكانيكية مع الدين بإعطائه إشارة خلق الساعة الكونية، وتوقيتها، وربما إنهائها، لكنها كذلك تفصل الحركة عن عمليات خلق الكون الغيبية، وأدى طرحها بأن الشمس مركز المجموعة الشمسية وتكون المجموعة من سديم، إلى توجه العلوم نحو إعادة النظر في المعطيات الفكرية الأرسطية بشأن مصدر الحركة وبشأن الطبقات السفلى من تاريخ الكون والمادة، وبالتالي يفتح الآفاق لقراءة الظاهرات المادية الصغرى والمواد والكائنات المختلفة.
وهكذا فإن الفلسفة الميكانيكية وهي تنشئُ العلومَ الحديثة كانت تتعرضُ هي نفسها للزوال. فهذه الفلسفة الميكانيكية بتطبيقها على مجالات الحركة في أجسام أصغر، وظاهرات ذات تحولات مركبة كعمر طبقات الأرض وكيفية احتراق المواد وكيفية ظهور أنواع الأحياء لم تستطع أن تصنع إجابات علمية. كان تطبيقها على هذه الظاهرات يقوم على إرجاع عنصر التحول إلى عوامل خارجية وإلى غازات غير محددة، لكن تطورَ الصناعة الكبير كان يخضع هذه المواد المجهولة إلى الكشف، فغدت عوامل تحول المادة الفيزيائية والكيميائية تقوم على الذرات والجزيئيات الداخلية، وبدا يظهر أن المادة تتحول إلى طاقة والطاقة تتحول إلى مادة، وان قانون بقاء المادة قانون علمي أساسي.
أظهرت الجيولوجيا أن طبقات الأرض لها تحولات طويلة وأنها لا تتوقف عن الحركة. المواد كعناصر محددة تكشفت وظهر لتكوينها ولتمازجها قوانين محددة. تم اكتشاف تطور الخلية الحية، وأن أنواع الأحياء نتاج تطور تاريخي طويل.
إن كل أنواع الحركة هذه مغاير للحركة الميكانيكية وقوانينها، وكان ذلك يستدعي قيام فلسفة جديدة، تكشفُ الطبيعةَ المعقدة المركبة للحركة وأنواعها في كل أقسام العلوم الطبيعية والاجتماعية كذلك، والأخيرة قد دخلها زلزال التحول أيضا، وكان ظهور فلسفة جديدة يستدعي تفكيك الارتباط بين الفلسفة الميكانيكية والدين، ولكن أخذت المعضلة هذه تتعقد مع ارتباطها بالصراعات الفكرية والسياسية، حيث يلعب الدين التقليدي دوراً محوريا.
إن كشف أنواع الحركة في الأجسام الطبيعية من داخلها، وهو أمر يتناقض مع الفكر الديني التقليدي حيث الحركات قادمة من الغيب، قد ترافق مع تفكيك السلطات الدكتاتورية الدينية والسياسية، فأخذ «الشعب» ينتزع السلطات وراح المنورون يجدون في البناء الاجتماعي قوانين تطوره الداخلية بمعزل عن المؤثرات الخارجية الغيبية.
إن تركيز السلطة في البرلمان هو أشبه باكتشاف قوانين الحركة في المادة، والمادة هذه الكينونة المحتقرة من قبل الفلسفة الأرسطية والدينية السابقة غدت هي بؤرة الوجود.
إن رؤية أسباب التحولات داخل المادة الطبيعية والاجتماعية والبشرية، كان يعني صراعاً طبقياً بين المنتصرين على الإقطاع السياسي- الديني الحاكم، فقد ظهر جناحان للمنتصرين، الجناح البرجوازي الذي آلت السلطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إليه، والجمهور العمالي الذي كان عليه أن يعمل بشكل شاق وفي ظروف متدنية من أجل أن تنتصر وتحكم البرجوازية.
لهذا فإن هذا الانقسام الطبقي انعكس على فهم الحركة وفهم الفلسفة، وأخذت القوى البرجوازية تتحالف مع الأقسام الثقافية الدينية والمثقفين التقنيين من أجل إعادة صياغة الفلسفة بحيث تتوارى لغتها الثورية السابقة، ويتم كشف الحركة في المادة، من أجل أن تستمر العلوم الطبيعية والمصانع، دون أن يكون لهذا الكشف دلالات على الصراع الطبقي الدائر.
بدأت هذه الحركة الارتدادية التقنية الفلسفية في البلد الذي انتصرت فيه البرجوازية أولاً وهو إنجلترا، فظهر جان لوك وديفيد هيوم وجون ستيوارت ميل وصاغوا فلسفةً تعتمد على إنكار وجود قوانين موضوعية في المادة، المستقلة عن الوعي، بل قالوا انه لا يوجد سوى الحس البشري وهو الذي يدرك، والعملية العلمية تدور في مجال هذا الحس فقط، وما هو خارجه ليس في بؤرة الوعي. وعضدت ألمانيا هذه الفلسفة لأسباب تاريخية، فالبرجوازية كانت متخلفة عن قريناتها في البلدان الأوربية الأخرى، وقد ساندت الإقطاع البروسي العسكري، فتأسست فيها فلسفاتٌ متضادة كثيرا، منها الكانتية ومؤسسها عمانويل كانت وهو نفسه العالم الذي اكتشف السديم في المجرة وطرح تصوراً لكيفية نمو المجموعة الشمسية، حيث ركز هو الآخر على كون المعرفة حسية بدرجة أولى، ولكنه أكد موضوعية المعرفة وطرائق الوصول إليها، دون الوصول الكلي للحقيقة لأنه ستبقى أجزاء من الظاهرات خارج الكشف. أما الفلسفات المادية والجدلية فقد تنامت هي الأخرى في ألمانيا، فظهر الجدل لدى هيجل، ولكن جدل هيجل مبنيٌ على كون الفكرة المطلقة أو الروح هي التي تقومُ بالحركة، فهي فكرة مطلقة غيبية لكنها في حركة تالية تتحد بالطبيعة وفي حركة ثالثة تتحد بالعقل، وهذه التحولات الثلاثة تشير إلى حركة الفئات الوسطى الألمانية عبر منظور هيجل المتواري، حيث تنفصل عن الفكر الديني والسلطة المطلقة وتتحد بالمادة الطبيعية والفكرية، ثم تتوجُ في العقل الذي هو أيضاً الدولة البروسية!
إن الفئات الوسطى بالمنظور الهيجلي استطاعت أن تنفصل عن الدولة- الدين ولكن ليس بشكل كلي، فتتمظهر في حركة «الروح». وهذا أسلوب فلسفي يوناني وشرقي قديم. ولكن ما يهم هنا هو طريقة الروح في التحول عبر موقف أول الذي يتم تجاوزه في حركة نفي مضادة، لأن الروح تعيش حالة صراع وتناقض، فتحل حالةُ تركيبٍ وتجاوز للنقيضين في موقف جديد، ولكن الموقف الجديد يستتبع وجود تناقض آخر يؤدي إلى حركة جديدة وهكذا. هذا المنهج الجدلي كان اختراعاً ألمانيا، أي ظهر في حالة ألمانيا الإقطاعية المتخلفة عن برجوازيات التحول الكبرى، وفي وجود الفئات الوسطى التي لم تتشكلْ كطبقةٍ قيادية، ومن هنا فالجدل يظهرُ في شكلٍ ديني مثالي موضوعي، فهناك الفكرةُ المطلقة أو الروح وهي المعبرة عن الطبقات العليا المسيطرة، لكنها تلتحم بالطبيعة والمادة المعبرة عن الطبقات الشعبية، وفي هذا السديم الفكري الاجتماعي، المعبر عن حالة ألمانيا القلقة، تدور فلسفةُ هيجل، منهجها الجدلي ثوري، وغلافها الفكري محافظ، وبين الثلاثينيات والأربعينيات من تاريخ ألمانيا وأوروبا في القرن التاسع عشر، تنفجرُ ألمانيا وتنفجر فلسفة هيجل معاً!
لم تحصل ألمانيا على فرصة تاريخية مطولة كي تشكل تحولها الديمقراطي، والبرجوازية تمشي في حضانة عسكرية من قبل الدولة، وجاء هيجل بجدله التحولي ليطرح منهجاً مهماً في فهم وتفعيل الحركة على مختلف الأصعدة، فانتقلت قيادة الحركة الاجتماعية إلى الفئات البرجوازية الصغيرة، ومنها ظهر فورباخ بماديته النافية لمثالية هيجل، وظهر اليسار الهيجلي، وهي قوى حاولت دفع البرجوازية لكي تنقض على الإقطاع دون فائدة.
وهذا هو ميلاد الماركسية. تشكلت في لحظتها الأولية تلك كنقيض للطبقتين الإقطاعية والبرجوازية معا. أي اندفعت نحو العمال كملاذ أخير من الجمود السياسي الاجتماعي. وهنا كانت أشبه بصرخة سياسية أكثر منها علما. ومن هذه الصرخات سوف يرى لينين الماركسية. وهذه القضية ستبقى مشكلة كونية للبلدان المتخلفة عن البلدان المتقدمة ولرغبتها القومية الحادة في اللحاق بالمتقدمين.
كانت عقلية «البيان الشيوعي» المكتوب من قبل ماركس وإنجلز تطرح تصوراً كونياً لقرون قادمة وليس لحل إشكاليات الصراع الطبقي الراهن في ألمانيا نفسها، فكانت ألمانيا بحاجة إلى تشكيل تحالف برجوازي- عمالي يبعد القوى الإقطاعية العسكرية المتطرفة عن السلطة وليس لإزاحة البرجوازية التي لم تكن تحكم!
إن لغة المثقفين المنتمين للبرجوازية الصغيرة يسقطون هنا وعيهم السياسي التحويلي على الواقع الموضوعي فيطرحون مهمات غير ممكنة سياسيا، في إطار إيديولوجي مُسقط، وبطبيعة الحال يطرحون ذلك كصوت للطبقة العاملة، وهذا على المدى التاريخي صحيح، لكنه في الواقع الراهن غير واقعي، وتداخل المدى التاريخي واللحظات السياسية الراهنة، بمهماتها العملية الكبيرة، لا يتطابق ويتداخل بصورة جدلية، فهيمنة الطبقات العاملة تتم بعد قرون من التراكم السياسي والاقتصادي والثقافي لكنها كمهمة مرحلية غير ممكنة. وترتبت على لغة أقصى اليسار بمظاهرها الاجتماعية وثورتها هذه توجه البرجوازية الألمانية نحو أقصى اليمين، كذلك فإن ذهاب ماركس- أنجلز للعيش في إنجلترا أضفى على لغتهما الثورية العاطفية الألمانية بعداً أكثر موضوعية، وبدأت عمليات الاكتشاف العلمي العميقة للرأسمالية والعلوم، التي حصيلتها كتب موسوعية مثل «رأس المال» و«جدل الطبيعة» وغيرهما، لكن الاستنتاجات ظلت في الإطار التاريخي العام وليس داخل صراعات البنى الرأسمالية الوطنية بمختلف مستوياتها وليس البحث كذلك في كيفية التغلب على الدوائر المتطرفة سياسياً وفكريا.
إن انتصار البرجوازيات الكبيرة في الأقطار الرأسمالية الرئيسية تحقق بفضل انتصار أسلوب الإنتاج الرأسمالي وتوسعه العالمي وتدفق فيوضه على الفئات المالكة والوسطى، وأعطت ألمانيا نموذج الجمع بين الفكر الإقطاعي السابق والفكر البرجوازي التابع فكان الجمع بين أشكال الفكر الدينية والصوفية واللاعقلانية وبين أشكال من العقل والليبرالية المحدودة والمهيمن عليها وهي الثقافة البرجوازية- الإقطاعية الهجينة التي ترتبت على قيام البروسية البسمركية في السيطرة على البرجوازية الخاضعة. ومن هنا رأينا ألمانيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وهي تتخلى عن الجدل الهيجلي وتروجُ فيها الكانتية والكانتية الجديدة والوضعية المنطقية والتجريبية. يقول جورج لوكاش: «إن جدل هيجل حين يحاول السيطرة على هذه المسائل في منظور تاريخي، هو ذروة الفلسفة البرجوازية. إنه يمثل أقوى مشروع حاولته للتغلب على هذه المعضلات الجديدة: محاولة صهر طريقة قادرة على ضمان الفكر الإنساني كاقتراب لا محدود وانعكاس للواقع بالواقع نفسه»، «تحطيم العقل، جزء 1، ص 76 – 77».
إن مشروع هيجل يظل مشروع فئات برجوازية لم تتشكل كطبقة قائدة لعملية التحول، ولهذا هو مفكّكٌ بين منهج جديد وبناء تقليدي، وتخلي هذه الفئات عن الجدل واتجاهها للعلموية الوضعية، لكشف المادة الجزئية المحدودة المنقطعة عن قوانين بنية المادة الطبيعية والاجتماعية، فهي هنا تمثل البرجوازية التي تدير المصانع المحتاجة للتقنية، في حين أن اتجاهها للاعقلانية والصوفية وفلسفات الحياة هي للسيطرة على الوعي العام وإدارة الدولة والمجتمع، وهذا الانقسام بين وضعية علموية تجريبية وكانتية وبين فلسفة الحياة المتجهة للفاشية، جانبان يتكاملان يعبران عن هذا التزاوج الإقطاعي- البرجوازي وقد تحول إلى طبقة سائدة ذات أصول بروسية عسكرية وبرجوازية نهمة للاستيلاء على المستعمرات.
April 21, 2023
جمعية التجديد الثقافي
منذ أن ظهرت جماعة التجديد من أقبية السجن المكلل بالمعاناة وهي محط اشتباه عند الغالبية العظمى من الجماعات السياسية الشيعية، بسبب النشأة الغامضة للجماعة في أتون السجن ودعوتها لأشياء جديدة لا تتوافق مع الجو السياسي العاطفي الساخن لدى هذه الأغلبية. ظل أصل النشأة غامضاً، لكون الجماعة لم تصدر شيئا تاريخيا بهذا الصدد، فظهرت شائعات كثيرة أغلبها يربطُ الجماعةَ بمؤامرة بهدف زعزعة الصف الشيعي المتماسك الموحد. واعتبرت هذه الشائعات أن تكوينَ جماعةٍ سياسية تزعمُ الاتصالَ بالمهدي وأنها طليعة لقدومه العظيم، هو خطة مدبرة دقيقة، ولكن ما قـُدم من قبل الرافضين لهذا التشكل لا يعدو أشياء عجائبية لا يصدقها العقل، مثل أن زعيم الجماعة كان يُظهر معجزات بالاتفاق مع إدارة السجن، لكي يرتفع في نظر اتباعه القلة وقتذاك، الذين تضاعف عددهم بعد الخروج من السجن.
وإذا كان ذلك صحيحاً على هذا الافتراض فإنه من الصعب التصديق بأن هذه الجماعة هي مؤامرة بهذه الطريقة، فقد توجهت لإنتاج الفكر وإصدار الكتب وعقد الندوات وتوفير أجواء من البحث، من دون أن تكون كل هذه الثمار المتنوعة بمثابة (مؤامرة). ولا يمكن لمشعوذ مهما كانت قدراته أن يخلق تيارا فكريا. وإذا قال معارضو جماعة التجديد: إنها مؤامرة موجهة لتفتيت الصف الشيعي فإننا لم نجد شيئاً مسيئاً للشيعة أو لغيرهم من المسلمين في هذه الأدبيات.
أما إذا قيل: إنها جماعة موالية للسلطة فلماذا لا يُسمح بظهور جماعات سياسية موالية للسلطة؟ ولماذا لا تظهر جماعاتٌ أخرى محافظة معارضة؟ لكن لا توجد كذلك أدلة على موقف سياسي محدد لجماعة التجديد، فهي أقرب لجماعة فكرية تتسم بمرونة سياسية وببعد نظر ثقافي ولا تحشرُ نفسَها في زاوية، صحيح أن أطروحاتها الاجتماعية ضد الفقر والبطالة والاستغلال غير مرئية، لكن ذلك أيضاً هو موقف اجتماعي هي حرة في انتهاجه. والمهم هنا أنها تدعو إلى أفكار بالكلمة وهذا هو المميز، أما المواقف الفكرية فلها حساب مختلف.
إنها تطرح الاختلاف وتجتهد في البحث وهذا لا يضر أحداً لأن القضاء على الفكرة يتم بالفكرة لا بالقبضات القوية والعصي. وتبدو الجماعات الكبيرة المعادية لجماعة التجديد في وضعها الفكري المحافظ غير راغبة في اثارة أي جدل فكري، وهي تغلق الأبواب في بحث تاريخ الأديان والأفكار، وهذا ليس من حقها، بل من واجبها إطلاق حرية البحث حتى فيما يتعلق بالمذهب الشيعي نفسه، فهو ملكٌ للمسلمين وليس فقط حكراً عليها.
لكن جماعة التجديد في كتبها وأوراق بحوثها الكثيرة ومقالات أعضائها تتجنب الصراعات وتمتنع عن الإثارة كما هو الحاصل في بقية التيارات، ربما لإدراكها صعوبة مثل هذه الإثارة في وسط ديني محافظ، كما أن خطوات التجديد في الوعي الديني بحاجة إلى الحصافة وبعُد النظر والهدوء، فهذه مقدسات الناس وليست تجارة بضائع، وهو ما التزمت به الجماعة.
وهي لها حق الاجتهاد والتأويل في الموروث الديني من دون أن تلزم غيرها به كذلك. ونريد من يتهم هذه الجماعة بذلك أن يضع بين أيدينا دليلاً على إساءة الجماعة لرمز من الرموز الدينية، أو تحقيرها لعبادة وسوى ذلك من الأدلة، أما الاتهامات الجزافية فهو أمر خطر.
ان التركيز في لفظ (السفارة) وان الجماعة تزعم الاتصال بالمهدي عليه السلام وانها تمهد لعودته وغير هذا من الافتراضات، فلا يوجد دليل ملموس حول ذلك. لكن إذا خرجت الجماعات من أفق هذا التفكير النصوصي، ورأت ان رمزية المهدي أوسع من هذه المحدودية، وأنها رمزية خلقت ثورات فكرية وخصباً جدلياً وثقافياً كبيرين، فكم من ثائر قال ذلك، وكم من حركات في التاريخ الإسلامي الطويل نشأت على هذا التداخل بين الغيبي والواقعي، بل ان التاريخ الثقافي الشيعي نفسه مليء بمثل هذه الحركات.
وفي الثقافة السنية اندلعت ثورات كبرى وتشكلت مقاومة وطنية باسم المهدي، وكل هذا بسبب هذه الرمزية المتعددة الآفاق والاحتمالات، فيجب ألا تـُؤخذ بحرفية نصوصية وبانعدام للخيال الخصب والتأويل. ومن المؤكد أن رمزية الاتصال تعني تشكيل موقف سياسي ويجد القائمون على احتكار المعنى الرمزي أنه يجب ألا ينازعهم منازعٌ في هذا الاحتكار، ثم تم تحويل الصراع مع جماعة التجديد إلى هذه الجزئية الصغيرة وتم شحن العواطف حولها، ونسيان الجوانب الثقافية الأخرى، مما يؤدي إلى تحريض البسطاء الذين لا يعرفون أن المسألة ثقافية واجتماعية كبيرة، ذات أبعاد معقدة ومركبة، فيتم التركيز في تفصيل هدم المقدس والاعتداء على حرمة الدين. وحتى لو أن جماعة التجديد توجهت لهذا الهدم المزعوم فهل تستطيع أن تفعل شيئاً؟ هل تستطيع أن تزيل حجراً واحداً من هذا الإيمان؟ بطبيعة الحال هذا غير ممكن، ولهذا ما الداعي للخوف والتناحر؟
مشروع جمعية التجديد
حين أصدرت جمعية التجديد الثقافي مشروعها في عدة كتب تحت اسم «عندما نطق السراة»، أبهرتني الجمعية بهذا النتاج الثقافي، فلأول مرة يقوم مثقفون بحرينيون بإنتاج عمل فكري ثقافي واسع، خلافاً لكل الجمعيات السياسية التي دأبت على إنتاج الشعارات وتعطيل العقل المنتج الناقد، فلم يظهر لها إنتاج فكري متميز خلال العقود السابقة، وهو أمر كان يدل على سيطرة العفوية والتلقائية السياسيتين، في حين أن جمعية التجديد التي اختارت الظل قامت بما عجز عنه أولو القوة والبأس في هذا المضمار الفكري.
فهي قد مضت إلى أكثر جوانب الفكر صعوبة وهو مناقشة الأسس الفكرية التي قامت عليها هذه المنطقة، خاصة أديانها، سواء كانت القديمة المتمثلة في الأساطير والديانات ما قبل التوحيدية، أو مناقشة الأديان السماوية، وقمتها العربية: الإسلام.
وقد ظهر ذلك فيى شكل ملتبس، أي عبر كتب بلا أسماء كُتاب، وقد خيل إلي أن جماعة التجديد تعيد إنتاج عمل إخوان الصفا، الذين قاموا في العصر العباسي بكتابة بحوثهم من خلال اسم جماعي، حذراً من السلطات السياسية والمذهبية المتعددة الجامدة الواقفة ضد كل تجديد.
ولكن هذا الحذر لا معنى له في العصر الراهن، بل من شأنه إخفاء جهود الباحثين، وتطورهم الفكري داخل جماعتهم، وإسهام كل منهم، ومعرفة المتقدم البارز من المشارك البسيط الخ.. وبالتالي تحديد خطوط التطور الفكري العميقة والإسهامات في بلورتها.
قرأت بعضاً من هذه الكتب، فوجدتُ نظرات مثيرة ومحاولة جريئة لتجاوز تناقضات المراحل الفكرية، فتلك الهوة بين ما قبل الأديان، وعالم الأديان، ما بين أسطورة مثل جلجامش أو تموز، وبين رموز الأديان التي لم يقبل الفكر الديني مناقشتها، بل إنه اعتبر العالمَ الفكري القديم عالماً وثنياً جديراً فقط باطمس والإلغاء، إن هذه النظرة الدينية التقليدية تم نسفها في مطبوعات جمعية التجديد .
كذلك فإن الخلاف الطويل بين الدينيين عامة سواء كانوا يهوداً أم مسلمين الذين يرجعون أصل الأنسان إلى السماء، وبين العلميين الذين يرجعون التطور إلى ظروف البيئة البحتة من دون تدخل غيبي، قامت الجمعية كذلك بإيجاد مخرج له هو الآخر.
وسلسلة التخريجات لبؤر التضاد الحاد بين الوعي الديني والوعي العلمي، تمتد إلى إلغاء التضاد بين الدين والعلم، وبين الشريعة والحداثة الخ..
ومهما كانت طبيعة هذه التخريجات فهي تغدو بادئ ذي بدء مبعث تقدير بأن أناساً مجهولين (لم يشيروا إلى أسمائهم تواضعاً) قاموا بهذه المأثرة، وهي الدخول في قضايا المنطقة التراثية بكل الغامها وقاموا بالبحث الطويل الموسع فيها.
وهي مأثرة بالنسبة إلينا نحن البحرينيين أن يقوم مواطنون لنا بمثل هذا الجهد الفكري الطويل والعميق وبنكران ذات وبتوجيه الوعي نحو التحديث والتطور مع وجود كل دوائر التعصب والإلغاء.
والدهشة تتشكل بسبب أن المثقفين في جمعية التجديد لم تظهر لهم أبحاث مستقلة سابقة، أو لم يُعرف لديهم باحثون نشروا كتباً في هذه الجوانب العويصة حسب علمنا، التي تحتاج إلى سنوات طويلة من القراءة والبحث، ثم فجأة تصدر كتبٌ موسوعية تحلل الخليقة في مراحلها القديمة كافة معتمدة على التراث الديني، فذلك أمر يدعو إلى العجب بأوسع معانيه.
لأن التجديد يحتاج إلى تراكم ثقافي وتجريب وشخوص كتابية محددة، وإسهامات أولية وتعديلات وأخطاء وخبرة الخ.. أما أن يظهر مشروع هكذا ناجز خاصة في طوره الديني القديم المتعلق بالأديان وتاريخ المنطقة، فهو أمر يحتاج إلى حيثيات وتأريخ وأدلة.
والمؤكد أن بعضاً من جماعة التجديد عاشت في السجن؛ فقرأت كثيراً وتأملت، فالسجن مدرسة كبرى، وهذا المنحى التجديدي المعارض للسيطرة الدينية التقليدية، لا يتشكل إلا في مثل هذه المناخات، وأنا لا أنكر حتى عمليات الهرطقة التي تحدث كثيراً في المجموعات الدينية، حين تزعم الاتصال بالغيب الألهي؛ بهذا الشكل أو ذاك، فهذه ثورات وطفرات معبرة عن صراعات في الوعي الديني، يبحث من خلالها عن استقلاله الفكري، ويكوّن فيها جماعته المميزة ثم ينخرطُ في السيرورة القانونية للفكر الديني نفسه مع معارضته التي حصل عليها بتضحياته.
إن جماعة التجديد إذن دخلت منطقة مليئة بانواع الألغام كافة، فحين اختارت الانفصال عن التفكير المذهبي السائد في جماعتها، اختارت الصراع والاختلاف، وبالتالي شكلت انشقاقاً، ومهما كانت خلفية وجذور هذا الانشقاق، فلا بد أن تكون له رؤيته، فهل هو انشقاق لتحطيم الجماعة أم هو لتطويرها؟ هل هو عمل نضالي لتغيير حياة الجمهور من تخلف واستغلال وعبودية ثقافية أم هو لتكريس هذه الجوانب؟
وبطبيعة الحال فإن الانشقاقات والصراعات الدينية الفكرية غالباً ما تقوم على أرضية الفكر الديني الواحد، فهي لا تنفصل عنه، بل تشكل رؤيةٍ جديدة داخله، وياخذها التيارُ السائد باعتبارها جريمةٍ وتمزيقاً للجماعة، في حين يعتبرها التيار الآخرعملاً تغييراً ونهضويأً واتساعاً لأفق الجماعة بطرح بدائل أخرى.
والجماعةُ التقليدية هنا لا تواجه انشقاقاً على مستوى الفصائل السياسية، التى هي متعددة، بل تواجه انشقاقاً في الرؤية المذهبية ذاتها، في كيفية رؤية العقيدة، فتراه الجماعةُ المنشقةُ باعتباره إصلاحاً على طريقة مارتن لوثر البروتستانتى في مواجهة كنيسة البابا، في حين تراه الجماعة التقليدية انحرافاً وخطراً على الإيمان والعقيدة وتحول مارتن من مصلح إلى كافر ومنبوذ!
ونحن علينا أن ندرس، لا أن نحابي أحد الطرفين، فالدرس الموضوعي يقيد الجانبين.
ولهذا فإن الجانب القديم، جانب القوى الدينية السائدة، يرى عمل المنشقين، ذا طابع سياسي تفكيكي للجماعة، هدفه زعزعة الطائفة، في موقفها السياسي المتحد. فيغدو لديها تاريخ الجماعة المنشقة، وهي هنا جماعة التجديد، جماعة (مندسة مغرضة)، فتدخل عمليات التصوير البوليسية لتاريخ الجماعة المنشقة، وأنها مجرد زرع، لا أصول ولا جذور لها في تاريخ الطائفة. وأنها هي الجماعة الأصيلة النابتة في الشرعية (وهناك مسلسل قصصي في هذا).
وعمليات التصوير البوليسية هذه، لا تستطيع أن تبرر مهما تشكلت بدلة حقيقية أو موهومة، نمو جماعةٍ فكرية ما، فكلُ الجماعات المنشقة وكلُ الأحزاب التي صارت ظاهرات كبرى فيما بعد، كانت جماعات منشقة، وكل الملل والنحل، كانت في بدئها انحرافاً، ومهما كان الزرع اصطناعياً فإنه إذا وجد تربةٍ موضوعية للنمو سوف ينمو، فالمشكلة تعود الى التربة نفسها، وتقبلها للأفكار المنشقة واحتضانها لها!
ونحن لا ندافع عن عمليات الزرع في أجسامنا السياسية التي هي متعددة وكثيرة، بل نقول إنها لا تبرر نمو الفكرة وتوسعها.
وبطبيعة الحال فإن خيارات الجماعة الجديدة لا يمكن أن تفلت من الصراع السياسي الذي ظهرت فيه، فإن التجديد إذا اختارت الاقتراب من الليبرالية السياسية، ومن طرح سياسة وطنية لا طائفية، فهذا أمر يظل يُدرس فى إطار هذه الليبرالية الدينية، وإذا اختارت الطرح العقلاني فهذا يظل مدروساً في ظل هذه الدائرة، فتظل الخيارات السياسية في نهاية المطاف هي التي تحدد مدى عمق هذه الليبرالية، هل هي تصطدم بالقوى المتنفذة في الثروة العامة؟ هل تدافع عن الطبقات المحرومة؟ وفي أي عمق واتجاه تشكل ليبرالتها الدينية هذه هل هي بالانفصال عن الدوائر البيروقراطية الاستغلالية أم معها؟ هل تفضح الفساد أم تدافع عنه حتى بالسكوت؟
إننا لا يمكن أن نضع جماعةٍ ما في دائرة مغلقة، فنحكم عليها بالخيانة الأزلية، أو النظافة المطلقة، فالجماعات الفكرية السياسية خاضعة لحراك لا يتوقف، فقد تبدأ جماعةٌ بالوطنية وتنتهي بالطائفية أو العكس، وقد تبدأ جماعةٌ بالدفاع عن المستضعفين وتنتهي كجلادين لهؤلاء المستضعفين أنفسهم! ويتحدد موقفنا من أي جماعة عبر شريط ممارستها الطويل، وكيف تصوب برامجها تعبيراً عن القوى الشعبية ومطالبها، فهل تغوص نحو المضمون النضالي للجمهور أم سوف ترتدي عباءات اللغة والمذهب لتدافع عن اللصوص؟
ومن هنا إذا أردنا معرفة مضمون أي جماعة فعلينا أن نقوم بقراءة وثائقها، وهذه جماعة أصدرت كتباً فعلينا بقراءتها قبل أن ندمغها، بل علينا أن ننتظر تطور مفاهيمها ونرى ممارستها على الأرض.
علينا أن ندخل إلى صلب رؤية جمعية التجديد في بعض القضايا الكبرى التى طرحتها في كتبها، والتي عنونتها بعنوان رئيسي وهو (عندما نطق السراة)، ففي أحد كتبها وهو بعنوان (التوحيد: عقيدة الأمة منذ آدم)، ترفض الجمعيةُ الفكرةَ الموضوعية المنتشرة في أغلبية كتب البحوث بأن الإنسان تدرج طويلاً حتى وصل إلى عبادة الآلهة ثم الإله الواحد، وتصر في هذا الكتاب على أن الإنسان كان توحيديا حتى وهو في أول ظهوره وتخلفه، وهى تفند دراسات الباحثين التحديثيين العرب والأجانب بهذا الصدد كإسماعيل مظهر أو عباس محمود العقاد أو محمد شحرور. يقول العقاد حسب استشهاد الجمعية: (يعرف علماءُ المقابلة بين الأديان ثلاثةَ أطوارٍ عامة مرت بها الأممُ البدائية في اعتقادها بالآلهة والأرباب، وهي دور التعدد، ودور التمييز والترجيح، ودور الوحدانية)، (ص ١٤ – 15)، ويضيف العقاد حسب استشهاد الجمعية رابطاً الأديان بظروف الحياة الاجتماعية: (ترقي الإنسانُ في العقائد كما ترقى في العلوم والصناعات. فكانت عقائدهُ الأولى مساويةٍ لحياته الأولى، وكذلك كانت علومه وصناعاته، فليست أوائل العلم والصناعة بأرقى من أوائل الديانات والعبادات)، ص 14.
ثم تفند الجمعيةُ أقوالَ العقاد فتقول: (فالعقيدة في نظر العقاد إنتاج بشري وليست وحياً سماوياً، تطورت الوحدانية بمرور الأزمان كما تطورت العلوم!)، ص16 .
وهي هنا لم تفهم الوحي والتطور كما عرضهما العقاد والمثاليون الموسوعيون عموماً، فالوحي لا يتشكل في الهواء، بل هو يتمظهرُ ويتجسدُ في البشر واللغة المحددة وفي الظروف والصراعات البشرية؛ وهو جدل اجتماعي بين الغيب والإنسان، بين النبوة والجماعة، بين الإله والواقع الخ..
لكن الجمعية تضع الأفكار الدينية في المطلق، بلا جذور اجتماعية وبلا تاريخ. وتركز على قراءة التاريخ الغيبي في النصوص الدينية المفصولة عن زمانها ومكانها. ثم تحاول أن تجد كذلك جوانبَ إيجابية وتقدمية داخل هذه النصوص المقطوعة الصلة بالبناء الاجتماعي.
فالتوحيد لديها كان موجوداً حتى عند الإنسان البدائي، وهو نظرٌ لا يصمد لأي تاريخ ثقافي، وهي ترى التوحيدَ وكأنه هو التاريخ الديني العربي وحده، لكنها كالباحثين القوميين الخياليين تعتبر أغلب سكان المنطقة عرباً وأن حضاراتها عربية، وهو أمر لا يصمد للتحليل الموضوعي كذلك؛ وهو فهمٌ روج له العروبيون المتطرفون ويعتبر أحمد داود الكاتب السوري المتعدد المواهب نموذجاً له، والجمعية تستشهد به كثيراً.
نقول الجمعيةُ (هكذا بدأت حياة الإنسان على هذه الأرض بالتوحيد لله الواحد الأحد)، واستمرت عقيدة التوحيد في هذه الأمة (حين تحولت من حياة الكهوف والتقاط الثمر، إلى استئناس الحيوانات و تدجينها بالرعي)، ص٢٦.
فأي أمة هذه؟! فلم توجد أي أمة عربية أو غير عربية حينئذٍ، بل جماعات بدائية متوحشة، وقبائل صغيرة، تعبدُ الأرواحَ والحيوانات الخ.. وبعد آلاف السنين بدأت رحلة الحضارة وتشكلت الأديان بتعددية آلهتها.
إن هذا ما تطرحه البحوث وقد أصبحت بديهية لا يجادل فيها أحد. ثم تدخل الجمعيةُ آيات القرآن في هذا المسار الخيالي الذي تشكله بصورة غير موضوعية. وهي تظن أن آيات القرآن هذه تنقض ما أجمعت عليه التواريخ والعلوم. في حين أن آيات القرآن المتعلقة بالتوحيد تتحدث عن تاريخ العرب في المنطقة وفي الجزيرة العربية فقط، حيث بدأ التوحيد في قمة الحضارة المصرية والذي تأثر به اليهود وشكلوا منه ديانة توحيدية، انعطفت إلى الجزيرة العربية وبدأ التوحيد حينئذٍ.
لكن حتى هذا المسار المعروف تحاول أن تنقضه جمعية التجديد في كتابها هذا، فالمصريون كانوا موحدين في تصورها منذ البداية وهي تستنكر ما هو بديهى بسخرية فكأن الباحثين زعموا على حد قولها: (إن الحضارات العربية القديمة في مصر أو بابل تعجُ بالآلهة والأوثان كالإغريق والرومان!). لكن هذه بديهية لا يبادل فيها طالب.
ولديها على العكس إن الفراعنة والبابليين كانوا موحدين، فلم الحاجة إذاً إلى الأديان السماوية وهي التتويج للسابقين؟! إنها تستند الى جمل صغيرة مقطوعة السياق من باحث أو اثنين لتعضيد ذلك الكلام غير الدقيق.
يتراوح خطاب جمعية التجديد الفكري بين تكريس النصوصية الغيبية وبين الآراء العلمية والنقدية الوامضة.
فهي تقول في مقاربة مع المنهجية الموضوعية:
( لقد نص «فرانسيس بيكون» على فكرة أن الإنسان لن يستطيع السيطرة على الطبيعة إلا عن طريق اكتشافها بالعلم، ولكن لكي يفعل ذلك ينبغي أن يخضع لها! بمعنى آخر: لكي نفهم القوانين التي تتحكم بالطبيعة ينبغي أن ندع الطبيعة تتكلم لا أن نتكلم عنها)، مفاتح القرآن والعقل، ص 8 -86.
وتكمل الجمعية في تلخيص مهم (القرآن والطبيعة والأنفس، أمرٌ واحدٌ، آيات ينبغي الخضوع لاكتشافها).
إن هذه الفقرة الجيدة وغيرها المماثلة هي اقتراب من مدرسة تقنين الطبيعة المخلوقة للذات الإلهية، بخلاف مدرسة الخلق الإلهي المستمر للطبيعة. وكلاهما مدرستان مثاليتان، لكن الأولى تؤمن بوجود قوانين موضوعية للطبيعة والوعي والوجود (مثالية موضوعية)، ومن أعلامها ابن رشد في حين أن الأخرى ترفض ذلك، وترفض وجود قوانين موضوعية ومن أعلامها الغزالي (مثالية ذاتية).
وفكر الجمعية حائرٌ بين المدرستين، فهو فكرُ يحاول أن يبحث عن موضوعية الوجود، ثم يضيف عليها الكثير من الغيبيات والإسقاطات المعاصرة من العلوم الحديثة مما يلغي تلك الموضوعية.
فهي تؤمن بوجود تطور موضوعي للوعي الديني وكذلك لا تؤمن بوجود مثل التطور.
فبرفضها وجود سببيات موضوعية للتطور الديني يصبح تاريخ الأديان بلا قيمة، كما لا تصبح هناك قوانين موضوعية لتطور الإسلام، فالمندائيون (الصابئة) والحنفاء هم شكل آخر للإسلام، وليس أن الإسلام تتويج لهذه الحركات التوحيدية المحدودة الجزئية، لأنه غدا ثورة شعبية. وبالتالي كذلك لا توجد تباينات في البناء بين حكم الخلفاء الراشدين والحكومات الشمولية التالية، وبالتالي لا يُفهم تباينات خطاب الإمام علي الثوري الشعبي الجلي عن خطابات الأئمة والفقهاء المحاصرين بين أشداق الاستبداد في المراحل التالية والذين غاصوا في الغيبيات الشديدة بسبب ذلك.
فنتيجة لقيام الجمعية بفصل الأديان والمذاهب عن جذورها وأبنيتها وكون الخطابات الدينية والفكرية هي جزء من حركة صراع اجتماعي، لا تستطيع جمعية التجديد الانتقال العميق الكلي من المثالية الذاتية إلي المثالية الموضوعية.
هنا يمكن الاستفادة من فكر هيجل، الفيلسوف المثالي المؤمن ولكن الدارس بشكل موضوعي للأديان وتطوراتها.
فلتطور الإنسان ككائن بيولوجي قوانين، ولتطور الأديان قوانين، ولتطور المذاهب والمجتمعات قوانين، ومن دون الدرس الموضوعي المستقل عن الكتب الدينية وعن المأثور الشعبي عامة، لا يمكن الانتقال إلى العلوم الحديثة التي لها شروط مختلفة عن الوعي الثقافي للعصور السابقة. وبعد التجذر في هذه العلوم يمكن مراجعة المأثور والنظر له بشكل موضوعي.
هذه الحيرة الانتقالية بين المثالية الذاتية والمثالية الموضوعية تعبر كذلك عن جانب مختلف عن الحركات المذهبية التقليدية السائدة التي تتجمد عند المثالية الذاتية، فلا تبحث عن سببيات موضوعية للتطور الديني، فتعبر بهذا عن كتل سياسية شمولية، ترفض البحث والديمقراطية، وتعيد إنتاج النص الديني كما كان في المرحلة التقليدية التي سيطر فيها الإقطاع بشكل كلي، ومن هنا نجد الحركات التقليدية تناوئ أي حركة تغيير وزعزعة للقوى التقليدية المسيطرة على الجماعة، فأي تحرك سياسي لدى هذه القوى التقليدية يتم ولكن تحت هيمنتها، فهي تستفيد من الأدوات الديمقراطية لنشر سيطرتها الاستبدادية، بخلاف جمعية التجديد التي تقوم بالتساؤل حول تاريخ الوعي الديني هذا وتقوم بالبحث فيه، رافضة جزءا وقابلة بجزء، حسب منهجها الذي بعد لم يتصلب فلسفياً، ولكنها في مراحلها الأولي فعلينا أن ننتظر ونتيح لها الوقت.
فلسفة الحداثة
لم يكن لدى الفلسفات الغربية وهي تخرج من العصر الوسيط الديني المسيحي سوى الاعتماد على فلسفة أرسطو مادةً ومنهجا وكانت التطورات الصناعية والتحولات المختلفة تدفع العلوم نحو استيعاب مختلف للحركة، وقد قام ديكارت ونيوتن بطرح مفهوم جديد للحركة هو الفلسفة الميكانيكية، وقد استعانت الفلسفة العربية الإسلامية السابقة بذات منهج أرسطو ورؤيته لفهم الحركة فكان أقصى جهد لها هو فهم حركة الأجسام في المكان. ولكن الأدوات والمعلومات التي توافرت في العصر الأوروبي الجديد، التي قام بها غاليلو وكوبرنيكس وغيرهما من العلماء أتاحت فهم حركة الكواكب والشمس بطريقة مختلفة عن السائد في العصر القديم، مما جعل ميكانيكا فهم الأجسام الكبيرة تسيطرُ على الوعي العام بالحركة. وقد تمظهرت هذه لدى نيوتن بقوانين الجاذبية. وحددت هذه الفلسفة ميكانيكا الأجسام عموماً حيث الحركة في المكان – الزمان تقوم على قوانين مادية محضة، أي على قوانين من داخل المادة، ولكن الداخل هنا بمعنى حركة الأشياء، فظل التناقض المادي الجسمي الخارجي الآلي هو المسيطر على فهم هذه الحركة الأبدية العامة، لكن كان لابد من وجود مصدر لظهور هذه الحركة فكان الإله.
وهنا تتآلف الفلسفة الميكانيكية مع الدين بإعطائه إشارة إيجاد الساعة الكونية، وتوقيتها، وربما إنهائها، لكنها كذلك تفصل الحركة عن عمليات خلق الكون الغيبية، وأدى طرحها بأن الشمس مركز المجموعة الشمسية وتكون المجموعة من سديم، إلى توجه العلوم نحو إعادة النظر في المعطيات الفكرية الأرسطية بشأن مصدر الحركة وبشأن الطبقات السفلى من تاريخ الكون والمادة، وبالتالي يفتح الآفاق لقراءة الظاهرات المادية الأصغر والمواد والكائنات المختلفة. وهكذا فإن الفلسفة الميكانيكية وهي تنشئُ العلومَ الحديثة كانت تتعرضُ هي نفسها للزوال.
فهذه الفلسفة الميكانيكية بتطبيقها على مجالات الحركة في أجسام أصغر، وعلى ظاهرات ذات تحولات مركبة كعمر طبقات الأرض وكيفية احتراق المواد وكيفية ظهور أنواع الأحياء لم تستطع أن تصنع إجابات علمية بحسب مستوى منهجها. كان تطبيقها على هذه الظاهرات يقوم على إرجاع عنصر التحول إلى عوامل خارجيةٍ وإلى غازات غير محددة، لكن تطورَ الصناعة الكبير كان يخضع هذه المواد المجهولة إلى الكشف، فغدت عواملُ تحول المادة الفيزيائية والكيميائية تقوم على الذرات والجزئيات الداخلية، وبدأ يظهر ان المادةَ تتحولُ إلى طاقة والطاقة تتحول إلى مادة، وان قانون بقاء المادة قانون علمي أساسي.
أظهرت الجيولوجيا أن طبقات الأرض لها تحولات طويلة وأنها لا تتوقف عن الحركة. إن المواد كعناصر محددة تكشفت وظهر لتكوينها ولتمازجها قوانين محددة. تم اكتشاف تطور الخلية الحية، وأن أنواع الأحياء نتاج تطور تاريخي طويل.
إن كل أنواع الحركة هذه مغاير للحركة الميكانيكية وقوانينها، وكان ذلك يستدعي قيام فلسفة جديدة، تكشفُ الطبيعةَ المعقدة المركبة للحركة وأنواعها في كل أقسام العلوم الطبيعية والاجتماعية كذلك، والأخيرة قد دخلها زلزال التحول أيضا، وكان ظهور فلسفة جديدة يستدعي تفكيك الارتباط بين الفلسفة الميكانيكية والدين، ولكن أخذت المعضلة هذه تتعقد مع ارتباطها بالصراعات الفكرية والسياسية، حيث يلعب الدين التقليدي دوراً محورياً.
إن كشف أنواع الحركة في الأجسام الطبيعية من داخلها، وهو أمر يتناقض مع الفكر الديني التقليدي حيث الحركات قادمة من الغيب، وقد ترافق هذا مع تفكيك السلطات الدكتاتورية الدينية والسياسية، فأخذ (الشعب) ينتزع السلطات وراح المنورون يجدون في البناء الاجتماعي قوانين تطوره الداخلية بمعزل عن المؤثرات الخارجية الغيبية. إن تركيز السلطة في البرلمان هو أشبه باكتشاف قوانين الحركة في المادة، والمادة هذه الكينونة المحتقرة من قبل الفلسفة الأرسطية والدينية السابقة غدت هي بؤرة الوجود. لكن رؤية أسباب التحولات داخل المادة الطبيعية والاجتماعية والبشرية، كان يعني صراعاً طبقياً بين المنتصرين على الإقطاع السياسي – الديني الحاكم، فقد ظهر جناحان للمنتصرين؛ الجناح البرجوازي الذي آلت السلطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إليه، والجمهور العمالي الذي كان عليه أن يعمل بشكل شاق وفي ظروف متدنية من أجل أن تنتصر وتحكم البرجوازية.
لهذا فإن هذا الانقسام الطبقي انعكس على فهم الحركة وفهم الفلسفة، وأخذت القوى البرجوازية تتحالف مع الأقسام الثقافية الدينية والمثقفين التقنيين من أجل إعادة صياغة الفلسفة بحيث تتوارى لغتها الثورية السابقة، ويتم كشف الحركة في المادة، من أجل أن تستمر العلوم الطبيعية والمصانع، من دون أن يكون لهذا الكشف دلالات على الصراع الطبقي الدائر.
بدأت هذه الحركة الارتدادية التقنية الفلسفية في البلد الذي انتصرت فيه البرجوازية أولاً وهو إنجلترا، فظهر جان لوك وديفيد هيوم وجون ستيوارت ميل وصاغ الأولان فلسفةً تعتمد على إنكار وجود قوانين موضوعية في المادة، المستقلة عن الوعي، بل قالوا انه لا يوجد سوى الحس البشري وهو الذي يُدرك، والعملية العلمية تدور في مجال هذا الحس فقط، وما هو خارجه ليس في بؤرة الوعي. وعضدت ألمانيا هذه الفلسفة لأسباب تاريخية، فالبرجوازية كانت متخلفة عن قريناتها في البلدان الأوروبية الأخرى، وقد ساندت الإقطاع البروسي العسكري، فتأسست فيها فلسفاتٌ متضادة كثيرا، منها الكانتية ومؤسسها عمانويل كانت وهو نفسه العالم الذي اكتشف السديم في المجرة وطرح تصوراً لكيفية نمو المجموعة الشمسية، حيث ركز هو الآخر في كون المعرفة حسية بدرجة أولى، ولكنه أكد موضوعية المعرفة وطرق الوصول إليها، من دون الوصول الكلي للحقيقة لأنه ستبقى أجزاء من الظاهرات خارج الكشف. أما الفلسفات المادية والجدلية فقد تنامت هي الأخرى في ألمانيا، فظهر الجدل لدى هيجل، ولكن جدل هيجل مبنيٌ على كون الفكرة المطلقة أو الروح هي التي تقومُ بالحركة، فهي فكرة مطلقة غيبية لكنها في حركة تالية تتحد بالطبيعة وفي حركة ثالثة تتحد بالعقل، وهذه التحولات الثلاثة تشير إلى حركة الفئات الوسطى الألمانية عبر منظور هيجل المتواري، حيث تنفصل عن الفكر الديني والسلطة المطلقة وتتحد بالمادة الطبيعية والفكرية، ثم تتوجُ في العقل الذي هو أيضاً الدولة البروسية!
إن الفئات الوسطى بالمنظور الهيجلي استطاعت أن تنفصل عن الدولة – الدين ولكن ليس بشكل كلي، فتتمظهر في حركة (الروح). وهذا أسلوب فلسفي يوناني وشرقي قديم . ولكن ما يهم هنا هو طريقة الروح في التحول عبر موقف أول الذي يتم تجاوزه في حركة نفي مضادة، لأن الروح تعيش حالة صراع وتناقض، فتحل حالةُ تركيبٍ وتجاوز للنقيضين في موقف جديد، ولكن الموقف الجديد يستتبع وجود تناقض آخر يؤدي إلى حركة جديدة وهكذا.
هذا المنهج الجدلي كان اختراعاً ألمانيا، أي ظهر في حالة ألمانيا الإقطاعية المتخلفة عن برجوازيات التحول الكبرى، وفي وجود الفئات الوسطى التي لم تتشكلْ كطبقةٍ قيادية، ومن هنا فالجدل يظهرُ في شكلٍ ديني مثالي موضوعي، فهناك الفكرةُ المطلقة أو الروح وهي المعبرة عن الطبقات العليا المسيطرة، لكنها تلتحم بالطبيعة والمادة المعبرة عن الطبقات الشعبية، وفي هذا السديم الفكري الاجتماعي، المعبر عن حالة ألمانيا القلقة، تدور فلسفةُ هيجل، منهجها الجدلي ثوري، وغلافها الفكري محافظ، وبين الثلاثينيات والأربعينيات من تاريخ ألمانيا وأوروبا في القرن التاسع عشر، تنفجرُ ألمانيا وتنفجر فلسفة هيجل معاً !
لم تحصل ألمانيا على فرصة تاريخية مطولة كي تشكل تحولها الديمقراطي، والبرجوازية تمشي في حضانة عسكرية من قبل الدولة، وجاء هيجل بجدله التحولي ليطرح منهجاً مهماً في فهم وتفعيل الحركة على مختلف الأصعدة، فانتقلت قيادة الحركة الاجتماعية إلى الفئات البرجوازية الصغيرة، ومنها ظهر فورباخ بماديته النافية لمثالية هيجل، وظهر اليسار الهيجلي، وهي قوى حاولت دفع البرجوازية لكي تنقض على الإقطاع من دون فائدة.
وهذا هو ميلاد الماركسية. تشكلت في لحظتها الأولية تلك كنقيض للطبقتين الإقطاعية والبرجوازية معاً. أي اندفعت نحو العمال كملاذ أخير من الجمود السياسي الاجتماعي . وهنا كانت أشبه بصرخة سياسية أكثر منها علماً . ومن هذه الصرخات سوف يرى لينين الماركسية . وهذه القضية ستبقى مشكلة كونية للبلدان المتخلفة عن البلدان المتقدمة ولرغبتها القومية الحادة في اللحاق بالمتقدمين .
كانت عقلية (البيان الشيوعي) المكتوب من قبل ماركس وإنجلز تطرح تصوراً كونياً لقرون قادمة وليس لحل إشكاليات الصراع الطبقي الراهن في ألمانيا نفسها، فكانت ألمانيا بحاجة إلى تشكيل تحالف برجوازي -عمالي يبعد القوى الإقطاعية العسكرية المتطرفة عن السلطة وليس لإزاحة البرجوازية التي لم تكن تحكم!
إن لغة المثقفين المنتمين للبرجوازية الصغيرة يسقطون هنا وعيهم السياسي التحويلي على الواقع الموضوعي فيطرحون مهمات غير ممكنةٍ سياسيا، في إطار ايديولوجي مُسقط، وبطبيعة الحال يطرحون ذلك كصوتٍ للطبقة العاملة، وهذا على المدى التاريخي صحيح، لكنه في الواقع الراهن غير واقعي، وتداخل المدى التاريخي واللحظات السياسية الراهنة، بمهماتها العملية الكبيرة، لا يتطابق ويتداخل بصورة جدلية، فهيمنة الطبقة العاملة تتم بعد قرون من التراكم السياسي والاقتصادي والثقافي لكنها كمهمةٍ مرحلية غير ممكنة .
وترتبت على لغةِ أقصى اليسار بمظاهرها الاجتماعية وثورتها هذه توجه البرجوازية الألمانية نحو أقصى اليمين، كذلك فإن ذهاب ماركس – أنجلز للعيش في إنجلترا أضفى على لغتهما الثورية العاطفية الألمانية بعداً أكثر موضوعية، وبدأت عمليات الاكتشاف العلمي العميقة للرأسمالية والعلوم، التي كانت حصيلتها كتب موسوعية مثل (رأس المال) و(جدل الطبيعة) وغيرهما، لكن الاستنتاجات ظلت في الإطار التاريخي العام وليس داخل صراعات البنى الرأسمالية الوطنية بمختلف مستوياتها وليس البحث كذلك في كيفية التغلب على الدوائر المتطرفة سياسياً وفكرياً .
إن انتصارَ البرجوازيات الكبيرة في الأقطار الرأسمالية الرئيسية تحقق بفضل انتصار أسلوب الإنتاج الرأسمالي وتوسعه العالمي وتدفق فيوضه على الفئات المالكة والوسطى، وأعطت ألمانيا نموذجَ الجمع بين الفكر الإقطاعي السابق والفكر البرجوازي التابع فكان الجمع بين أشكال الفكر الدينية والصوفية واللاعقلانية وبين أشكال من العقل والليبرالية المحدودة والمهيمن عليها وهي الثقافة البرجوازية – الإقطاعية الهجينة التي ترتبت على قيام البروسية البسمركية في السيطرة على البرجوازية الخاضعة.
ومن هنا رأينا ألمانيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وهي تتخلى عن الجدل الهيجلي وتروجُ فيها الكانتية والكانتية الجديدة والوضعية المنطقية والتجريبية.
يقول جورج لوكاش:
(إن جدل هيجل حين يحاول السيطرة على هذه المسائل في منظور تاريخي، هو ذروة الفلسفة البرجوازية . إنه يمثل أقوى مشروع حاولته للتغلب على هذه المعضلات الجديدة : محاولة صهر طريقة قادرة على ضمان الفكر الإنساني كاقتراب لا محدود وانعكاس للواقع بالواقع نفسه).
إن مشروع هيجل يظل مشروع فئات برجوازية لم تتشكل كطبقة قائدة لعملية التحول، ولهذا فهو مفككٌ بين منهجٍ جديد وبناء تقليدي، وتخلي هذه الفئات عنه واتجاهها للعلموية الوضعية، لكشف المادة الجزئية المحدودة المنقطعة عن قوانين بنية المادة الطبيعية والاجتماعية، فهي هنا تمثلُ البرجوازية التي تدير المصانع المحتاجة إلى التقنية، في حين أن اتجاهها للاعقلانية والصوفية وفلسفات الحياة هي للسيطرة على الوعي العام وإدارة الدولة والمجتمع، وهذا الانقسام بين وضعية علموية تجريبية وكانتية وبين فلسفة الحياة المتجهة للفاشية، جانبان يتكاملان يعبران عن هذا التزاوج الإقطاعي – البرجوازي وقد تحول إلى طبقة سائدة ذات أصول بروسية عسكرية وبرجوازية نهمة للاستيلاء على المستعمرات .
وكذلك فإن هذا الملمحَ تحول إلى كل البرجوازيات المسيطرة على الدول الرأسمالية الكبرى بأشكالٍ مختلفة تعكس تطورات الصراع الاجتماعي الفكري، حيث التجريبية والكانتية والوضعية المنطقية تنتجها البرجوازية الصغيرة أو الفئات المتوسطة عموماً في الجامعات كما أنها هي نفسها تنتجُ الفكرَ الديني المحافظ للهيمنة على الجمهور خارج الميدان الثقافي التخصصي التقني، مثلما هي تنتج الأدب والفن (الأسودين) للتجارة وإنتاج اللاعقلانية.
لقد تشكلت هذه العملية خلال تسليم الإقطاع القديم مفاتيح السلطة للبرجوازية وخلال نمو الاستعمار، وبالتالي تمت عمليات إبقاء الأديان التقليدية ومستوياتها المحافظة اللاعقلانية داخل وخارج الدول الغربية، وهكذا فإن الوعي الجدلي المتجه للقراءة العميقة للبنى الطبيعية والاجتماعية والفكرية، تم إبعاده عن الثقافة السائدة تلك بكل تراكيبها وطبقاتها المتعددة المتضادة كذلك.
إن عمليات الوعي الكلية لرؤية الظاهرات وكشف قوانينها تم التخلي عنها، وراح الوعي السائدُ يفككُ ويجزئ أي ظاهرة، ويحشرها داخل الحس، أو يحيلها إلى جزء حيوي من الذات، التي لا تكشفُ سببيات عميقة، كما يفعل المنهجُ الظاهري (الفينومينولوجي) أو كما تفعل الوجوديةُ في إحالةِ الوجودِ العام إلى ذاتٍ فردية يسيلُ وعيها في عمليات منقطعة عن سبر البنية التي تعيش فيها.
April 20, 2023
التسجيل المغلوط (الاستعمار البرتغالي)
حين تريد أن تكتشف مقاومة الشعوب في منطقة الخليج والجزيرة العربية للاستعمار البرتغالي فلا تعثر على مواد مهمة، بل هي نتفٌ صغيرة ضائعة متناثرة.
في حين إن البرتغاليين سجلوا الكثير جداً من الواقع لكن من خلال رؤيتهم الخاصة، باعتبار أن ما يقومون به هو إبادة لجنسٍ متخلف (بربري) هو جنس المسلمين، ولهذا فإنهم في كتبهم يسجلون المذابح التي تجري ضد هذا الجنس الذي يستحق الإبادة!
وحين تقرأ السجل الضخم لــ(أفونسو دلبوكيرك) باجزائه الأربعة والصادر عن المجمع الثقافي بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعبر ترجمة عظيمة للمترجم الدكتور عبدالرحمن عبدالله الشيخ، فتذهل كيف يقومون بتسجيل كل شيء في هذه الرحلات الدموية، لكن لأعمالهم ولدورهم الحضاري، دون أي مواد للشعوب المهاجَّمة، فلا تعرف أية مدن وقرى جرى إزالتها من على الخريطة!
ومع ذلك فهي موادٌ من الممكن استفادة الباحثين منها لتاريخ المنطقة المجدبة بدرس تطورها العمراني البشري العام.
وتوضح هذه الموسوعة التاريخية المكرسة لهذا القبطان الجزار، التناقضات السياسية التي حدثت في تلك الأزمنة ومواقف الدول الكبيرة: فارس والدولة العثمانية الزاحفة لالتهام المشرق ونضالات شعوب الخليج في ذلك الحين، وهي نضالات بطولية غير مسجلة لا تاريخياً ولا أدبياً.
ونظراً للقوة الهائلة للبرتغاليين قياساً بدول المنطقة المفككة والمتخلفة والدمار الهائل حسب المذكرات المسجلة عن القبطان سيء الذكر والذي سببوه في المدن، فإن مملكة فارس في ذلك الوقت لم تجد سوى التقارب مع البرتغاليين على ما فيه من فداحة دينية وتاريخية.
فقد كان الأتراك يزحفون من جهة ثانية على العراق وفارس نفسها، مسببين مجازر أخرى، ففي مدينة إيرانية قتل خمسون ألف إنسان.
وهذا قد فجر الصراع الطائفي بين الإيرانيين والأتراك على أوسع أبوابه، بدلاً من اختيار التعاون والتصدي المشترك لعدو واحد!
ومع هذا الزحف الهائل العثماني من تركيا إلى كل البلدان العربية، فإن مقاومتهم للبرتغاليين كانت محدودة جداً، وقد جرت بالنيابة عبر المماليك في مصر أو من خلال تأييد العرب في الخليج، لكن هذه الأمبراطورية العثمانية الشاسعة لم تشكل صراعاً جدياً مع الاستعمار الاستيطاني البرتغالي المتخلف.
هذه هي الظروف للتعاون الفارسي البرتغالي في ذلك الحين، ولترك دولة إيران حينذاك للبرتغاليين إمكانية التوسع في الخليج واحتلال القطيف والبحرين، وقاومت الشعوب الصغيرة بضراوة هذا التمدد المسلح، رغم إن مملكة هرمز وقتذاك وهي المطلة على بوابة الخليج قامت بقيادة ثورة عارمة ضد البرتغاليين.
وقد قام ممثلو السكان وبمختلف طوائفهم بالتوجه لقادة الدولة العثمانية لمساعدتهم ضد هذا الزحف، والتقوا بهم في بغداد خاصة، لكن المساعدات كانت ضئيلة، ولكن هذا كان تعبيراً عن وحدات وطنية فذة ضد أول استعمار، وترى كيف توجه ممثلو البحرين والقطيف بوفودهم للدولة العثمانية من أجل مساعدتهم في التصدي لذلك الاقتحام الشرس.
لكن الدولة التركية بقيت مستولية على البر ولم تطور نفسها للتصدي لموجات الاستعمار المتزايدة والمتطورة أكثر فأكثر.
في هذه الحقبة التاريخية تم اعتماد تسمية البحرين لجزر أوال، وغدت مناطق شرق الجزيرة كالقطيف والأحساء ذات أسماء خاصة، وهو أمر يشير إلى التوسع السكاني لهذه المناطق وتفكك وحدتها السابقة.
عموماً فإن تزوير التاريخ صار عادياً وكثيراً ما يبقى في حين لا تقدم القوى النضالية العقلانية رؤيتها في الأحداث تاركة الأمر لقوى التدخل الأجنبي وللمزورين من كل لون.
السودان بحاجة إلى الديمقراطية والسلام
أن الحكومات العسكرية المتتالية والحركات الدينية الطائفية والمحافظة رفضت الخيارات البرلمانية وصعدتْ على ظهور الشاحنات العسكرية إلى السلطة.
منذ إبراهيم عبود والعسكريون يحاولون ما لا يقدرون عليه، إخضاع هذا الشعب الطيب والبسيط والصبور والمكافح، وكل مرة يأتي عسكري كبيرٌ ينقلُ البلدَ لأزمة كبيرة ويصعدهُ تلة أخرى مليئة بالنار والدم.
نتذكر إبراهيم عبود وقمعه الشرس، ثم الثورة الشعبية التي أطاحت به وشعارها: اذهبوا أيها العسكر لثكناتكم. لكن العسكريين لم يتعلموا.
إنهم لا يذهبون، فيزداد الاهتراء والتمزق في الخريطة الوطنية. وهذا القفز إلى خشبة المسرح السياسي العالية كانت توفرها الأفكارُ الشمولية القادمة من الدول العربية وتتغلغل بين صغار الضباط الذين يقفزون على مستوياتهم الفكرية البسيطة والفقيرة ودرجاتهم الصغيرة، ليتحولوا إلى حكام لبلد كبير.
إن القفزة العسكرية الانقلابية تمثل أفكار المقامرة بمصائر الناس، وليس هي مثل حزب عريق يراكم التجارب والنضالات ويجعل الشعب يتطور ويغير نفسه، فهي تصعد مغامرين محدودي التبصر بالسياسة لا يعرفون سبل التطور ويقررون قرارات خطرة تلحق أضراراً جسيمة، وربما تكون السلطات السابقة قد سمحت لهم بالصعود وربما سمنتهم بعض الوقت فأكلوها.
والأفكار الانقلابية المشبعة بالبهارات القومية الزائفة كان يُلاحظ لدى التيارات الوطنية السودانية عمليات تغلغلها في الساحة السياسية، ونشرها بالأموال، وقد عبرتْ تلك التيارات منذ الستينيات عن خشيتها من هذين التسلل والفرض لهذه الأفكار، التي كانت إحدى الشخصيات التي تجسدت بها كالدكتاتور السابق جعفر النميري، الذي قام بإنجازات دموية كبيرة، والذي قفز هو الآخر على حزب الأمة وعلى الانتخابات والدستور، ثم أراد أن يعجن التيارات السودانية كلها في عجينة واحدة، ملغياً الاختلافات الفكرية والسياسية، وأنشأ ما سُمي الاتحاد الاشتراكي، وقد فرضه بالقوة، وساعده تصاعد دور الحكومات الشمولية في مصر وليبيا خاصة.
كانت نتائج الأفكار الشمولية (القومية) انها بدأت تمزيق خريطة السودان. كان السودانيون شعباً ذا عفوية سياسية وطنية متوحدة، لكن الأطروحات القومية والدينية المتعصبة، جعلت الجنوبيين المسيحيين يشعرون بالخوف من نزعات الشمال الجديدة، خاصة أنهم عاشوا الاضطهاد أكثر من غيرهم على مدى التاريخ.
وكلما ازدادت قبضة الشمال العسكرية تفكك السودان، وهو أمرٌ على النقيض من الشعارات التوحيدية التي تتفجر مع كل بلاغ عسكري من الخرطوم، وكان الشعب ليس بحاجة إلى البلاغات بل إلى السكك الحديدية والأعمال والتجارة والمساواة بين أقاليمه وقومياته وأديانه.
وزادت الحركاتُ المتاجرة في الإسلام الثقافةَ الشمولية العسكرية غنىً دمويا، وتفكيكا لخريطة البلاد التي كان يوحدها الرعاة والفلاحون ورجال الدين الشعبيون والقبائل والعساكر البسطاء، ولم تكن بحاجةٍ إلى الدبابات من أجل ذلك، كما أن هذه الحركات المتاجرة في الدين زادت أهل الجنوب والمناطق المختلفة، خوفاً فحملوا السلاح، ثم انتشرت النار في بقية الأقاليم.
كلما جاء فصيل عسكري وعد الشعب بالكثير من الانجازات والتغييرات، وقد جاء العسكر في الفترة الأخيرة فكانوا تتويجاً لذلك التاريخ المكفهر.
تصارع العسكريون الدينيون الحاكمون فيما بينهم وراح كلُ قسم يزايد على الآخر فيما يقدمه من مكاسب للشعب، وتصارعوا مع قوى الأقاليم المنفرطة من السيطرة الحكومية، وراحوا يجمعون خيرات النفط من دون إصلاحات معيشية بسيطة للجمهور.
الحل هو أن يتركَ العسكرُ الحكمَ، ويعود الحكم المدني، ويُزال استغلال الإسلام للتجارة السياسية، وتجرى انتخابات ديمقراطية على ما كان يجري من انتخابات في السودان في عصره الديمقراطي الشفاف البسيط قبل عهود العسكر، مع إجراء التطورات الضرورية بعد كل هذه التحولات والكوارث.
بطبيعة الحال لن يحدث ذلك ولن يخرج العسكر وهم الضباط الكبار في الواقع وليس الجنود المساكين الذين يسوقونهم لمعارك لا دخل لهم فيها.
كانت «إنجازات» حكومات العسكر كثيرة على أهل السودان؛ فقد صار الإقليم الغني سلة العرب الغذائية محلاً للمجاعات، وتشرد كثيرٌ من سكانه، وافتقروا أشد الفقر، وتصارعوا أحزاباً وأدياناً ومناطق، وسمحوا بالتدخلات الأجنبية من كل حدب وصوب، وبكل لون وطريقة.
ستكون هي النتيجة الأخيرة من هذا الفصل حين يعترف العسكريون بعجزهم وينسحبون تاركين لأهل السياسة الوطنية تدبر أمر السودان من أجل إصلاحه وإعادته إلى طريق الديمقراطية والسلام
April 19, 2023
إعدام مؤلف
مسرحية فكاهية من فصل واحد
المشهد الأول
تتقدم المذيعة إلى مقدمة الخشبة وهي تحمل الميكروفون وتقول :
ـــ المذيعة : يسرني أيها السيدات والسادة تقديم المؤلف البارز الأستاذ حمدون الأعرج ، وهو مبدعٌ غنيٌ عن التعريف ، فقد ملأ الآفاق بصوته ، وجلجل في الفضاءات باسمه وبشخصياته وبرواياته ، حتى إستحق العديدَ من الجوائز وصال وجال في الأقطار !
هل يمكن يا أستاذ حمدون أن تلخص لنا مشوارك الأدبي ولو بكلمات موجزة ونحن واثقون بأن هذا التلخيص لن يستطيع بأي حال من الأحوال أن يطفئ ظمأ المشاهدين ، أو أن يحيطَ بكل إبداعاتك الخصبة ؟
ـــ حمدون : في الواقع لقد كانت انطلاقتي الأولى من خلال حرب العصابات ، أو بالأحرى من خلال الدعوة لحرب العصابات ، وكنتُ متحمساً بشدة في ذلك الوقت لإزالة عوالم الظلم بقوة السلاح ، فأنا لم أؤمن مطلقاً بأن السادة الجالسين على خزائن الفضة واللؤلؤ والزيت يمكن أن يتنازلوا للفقراء بهذه الجبال من الأطعمة والقصور والمعادن ، وانطلقنا بقوة . .
ـــ المذيعة: أين انطلقتم يا أستاذ حمدون في جبال الجمهورية أم إلى أمكنة اللهو والشراب ؟
ـــ حمدون: بل انطلقنا في الكتابة يا أختي ، إن المسألة لم تصل إلى مستوى الرصاص الفعلي . دَعونا ، ونَشرنا المؤلفات ، وتخاصمنا ، وتضاربنا في البارات، والحارات ، والنقابات ، لكن لحسن الحظ لم نطلقْ رصاصةً واحدة ، وكل الذي حدث أنه في التدريب أطلق علي أحد الرفاق – لا بارك الله فيه – رصاصةً على ساقي فأصبت بعرجٍ ولهذا سُميت بذلك ، وكان اسمي مختلفاً . . فقد كان اسمي حمدون النبيه ، وذلك يعود لا للنباهة بل لأني من مواليد جزيرة النبيه صالح !
ـــ المذيعة: وبعد ذلك هل واصلت التدريب الأعرج ، أقصد التدريب على عرجٍ ؟
ـــ حمدون: لحسن الحظ قام رئيس الجمهورية السابق ، حفظه الله ، بل أسكنه فسيح جنانه ، بحركةِ هجومٍ سريعةٍ علينا ، وتم إلقاء القبض على كل تلك المجموعة التي لم تقاتل إلا باللسان . وتم تنقيعنا في المحابس المختلفة ، فبعضنا سكن قممَ الجبال المغطاة بالثلوج ، في عز الشتاء ، وآخرون تم إلقائهم في صحراءِ جهنم ، المعروفة في جنوب بلادنا ، العامرة بكل ألوان الطيف العقابي.
ـــ المذيعة: وهل كانت المعاملة حسنة وحصلتم على هدايا عيد الميلاد والحج؟
ـــ حمدون: كانت المعاملة في منتهى الشكل الحضاري ، فقد كنا نأكل ونكتب ونقرأ الكتبَ وننام مع حبيباتنا ونشربُ العصائر المختلفة ونذهب ليلةً واحدة إلى أفضل فنادق خمس نجوم في البلد و(.. هامساً : كل ذلك في الحلم !) . . و . . نكتب رسائل مفتوحة إلى أهلنا ، ونتعشى في الساعة الرابعة عصراً ، ونصادقُ العدسَ مصادقةً أبدية.
ـــ المذيعة: وبعد هذه المعاملة الحضارية هل واصلتم دعوتكم المتطرفة إلى حمل السلاح ، أم قلتم وداعاً للسلاح؟
ـــ حمدون: في الواقع أن رئيس الجمهورية كان في منتهى الذكاء والطيبة والمرونة والحنكة السياسية ، فاستدعانا جميعاً وراح يحدثنا بلغةِ أهل الفكر والعلم ، فسألنا : هل قرأتم كتاب (رأس المال) لكارل ماركس؟ فأجبنا جميعاً : أننا لم نقرأ كتاب رأس المال ، وقال بعضنا همساً لم يصل إلى أذن الرئيس المعطوبة : كيف نقرأ كتاباً يحضُ على جمع المال ونحن ضد المال؟ فقال الرئيس: كيف تريدون أن تحطموا دولة رأسمالية دون أن تقرأوا رأس المال؟ لهذا فأنا أعطيكم مهلةً تاريخية لتعودوا إلى بيوتكم وتقرأوا هذا الكتاب وتصارعوننا بعلم ودراية لا بجهل وقلة رباية ، على شرط أن توقعوا تعهداً بالتخلي عن درب السلاح الذي لم يضر سوى زميلكم الأعرج وحده!
فقلتُ لرئيس الجمهورية بشموخ: بما أنني الوحيد المتضرر من هذه الحرب الأهلية فإنني سوف أوقع على هذا التعهد وأمتنع كلياً عن استخدام السلاح ضد دولتي الحبيبة ووطني الغالي!
وعانقني رئيسُ الجمهورية بقوةٍ وحب أبوي وفتح لي أبواب العمل والمجد! ومنذ ذلك الوقت كتبنا الروايات والمقالات وتركنا حرب العصابات!
المشهد الثاني
(المؤلف يفتحُ بابَ شقته الواسعة وحين يشعل الضوء يفاجئ بهجوم واسع النطاق تقوم به مجموعة من الشخصيات الغريبة الأشكال ، ويجد زوجته مربوطةً على كرسي وفمها مغلق بقطعة من الستارة الممزقة).
المؤلف: ما هذا يا سادة ؟ كيف دخلتم إلى شقتي؟ ليس معي (cash many) هنا ولكنني مستعدٌ لكتابة شيك على مصرفي ، بل شيك على بياض كذلك ، ولكن أرجو أن تزيحوا قبضاتكم الثقيلة عن جسمي!
الرجل – الضفدع: (وهو يجره إلى وسط القاعة) لا يا سيد نحن لسنا من اللصوص ولا القتلة ، بل نحن شخصيات مهمة في هذا المجتمع ، ولنا وضعنا الأخلاقي والقانوني الكبير ، لولا بعض التصرفات غير اللائقة التي قام بها أحدُ الأفراد المحسوبين على النخبة المثقفة !
المؤلف : تصرفاتٌ لائقة أو غير لائقة ما ذنبي أنا أن تمسكني من عنقي وتمنع الهواء عن رئتي . .
المرأة – الحية: (وهي تتقدمُ زاحفةً على الأرض) كيف . . وأنت ذلك الشخص المقصود ؟ ! أنت من أجرمت بحقنا !
المؤلف : يا سيدتي الزاحفة أنتم ربما أخطأتم في المنزل أو المنطقة أو القارة ربما فأنا لم أشتغل أبداً في برنامج الأسلحة الكيمائية أو الجرثومية ، ولم أساهم أبداً في تصنيع القنبلة النووية العربية.
الرجل – الضفدع: هل هي إهانة جديدة توجهها إلينا أيها السيد المؤلف ، هل تتصور إننا بقايا حرب جرثومية ما ، أو نتاج قبلة مجنونة من إرهابي ، لا! أيها السيد المؤلف نحن ضحاياك!
المرأة – الحية: نحن نتاجُ قبحِكَ الروحي!
الرجل – التابوت: (وهو يمد رأسه بوهن) نحن ثمرة خيانتك!
المؤلف: ما هذا ، ما هذا؟ تقتحمون بيتي وتسدون فم زوجتي الذي لم يُسد أبداً رغم كل محاولاتي في عدة سنوات ولو لمرة واحدة ، فهل أنتم مندوبو مسرح حديقة الحيوان التي سحبتُ نصي منها حيث لا يمكن أن أقبل بأقل من خمسين ألف دولار أمريكي ، ولهذا أرسلتكم كمسوخٍ وبقايا الحيوانات النافقة والمتضورة جوعاً والتي أعلنتْ الإضرابَ عن الطعام أكثر من عشر مرات احتجاجاً على الوساخة وعدم دفع الأجور وتشغيل حيوانات من بلاد أخرى ، لأجل اختطافي وتوقيع العقد بالقوة وتحت تهديد إغلاق الأفواه؟!
الرجل – الضفدع: أنظرْ! أنظر! (وهو يقربه من وجه المرأة – الحية) تمعنْ في هذه المرأة جيداً ، ألم ترها من قبل؟
المؤلف: آه . . نعم . . نعم . . رأيتها مرةً واحدة في كابوسي الأول عندما كنتُ في السجن ، نعم أنها أم الخضر والليف وعشيقة الأخطبوط.
الرجل – الضفدع (وهو يضغطُ عليه بشدة) تمعنْ فيها ، أنظرْ إلى جمالِها الذي كان هنا ولم يُعدْ موجوداً ، أليستْ هذه هي حصة بنت بلال ، التي كانت جميلة القد ، هيفاء ، ذات طلة بهية ، ونظرة أقحوانية ، وخلفية عربية ، وكانت راحلة بعيداً فغازلها الشابُ الوسيم ابن البلد الشعبي ، الذي أغتسلَ في زيتِ تشحيم السيارات ، وتطهرَ بطمي الحارات ، وأنشد أجمل البيانات ، فهجرتْ أوربا الخضراء وجاءت إليه تسعى ، واستراحت في صدره ، أليست هي؟!
المؤلف: يا سيد أنا لا أتذكر . . أيُّ مسخٍ هذه ، أنا صنعتُ آلاف الشخصيات ، مدينةً كبرى ، فمن أتذكرُ ومن؟ ثم كيف يُعقلُ هذا كله؟
الرجل – الضفدع: تطلعْ إليها ، هذه التي كانت غضةً بريئة ، نجمةً وردية في السماء ، ثم حولتَ زوجَها الرائع الذي لم يستطع أن ينضم إلى هجمتنا هذه ، بسبب انتحاره بغاز الأعصاب ، إلى مدمنِ هيروين بلا أي منطقٍ وبلا أي تبرير فني أو موضوعي ، وتحولت الخليةُ الشعبية التي كان من الممكن أن تتحولَ إلى الأساسِ الصالح للمجتمع إلى نزيفٍ يومي ، وعراكٍ بالنعال وعلب الطماطم وبزجاجات الكحول الفارغة لحسن الحظ ، وبدلاً من تلاقي الخضرة الأوربية والأرض اليابسة العربية ، صارا جرادتين متعاركتين على قشور الفول السوداني بعد كلِ سهرة تصلُ إلى الفجر ، فكان يغرزُ فيها أظافره وكلماته حتى صارت بهذا التشوه ، أإلى هذه الدرجة قمتَ بتشويهها وهي . . التي كانت . . والتي حصلت على ترشيح لمسابقة جمال الكون!
(تحاولُ زوجةُ المؤلف أن تتملص من قيودها وتصدر أصوات : ما . . ما . . ، لكن المؤلف الذي يتطلع إليها ، يبعد نظره عنها ، ويتكلم).
المؤلف: الآن بدأتُ أتذكر . . ثم غدت مثل الليمونة التي تــُركت في الشمس عشر سنوات ، فتغضن وجهُهُا وصارت مثل الساحرةَ التي تركبُ المقشةَ ، ولكن الأهم ما فيها هو حبها الهائل للنقود والجوائز والبيوت ، وللرجال الذين يهربون منها كما يهربون من الجدري والسرطان! أتذكرها الآن . . يا رجل قلْ أنها أم أحمد . . ملكة الموت في قصتي (الشريدة) ، لماذا هذا اللف والدوران؟
المرأة – الحية: (صارخة) أهكذا يصورون النساءَ يا حقير؟ أليس لديك أية رحمة؟ أهكذا تفعلُ بي وتتركني وتقطعُ التسلسلَ المنطقي العقلاني في القصة ولا تترك الرجلَ الذي هامَ بي يقبلني ويضمني في آخر لقطة؟ كنتُ أتحرق شوقاً لتلك القبلة واللمة يا ظالم!
الرجل – الضفدع: أنظرْ . . ومن تلك المأساةِ الرهيبة نتجت هذه المرأةُ ، هذا المسخ . . كان أفضل لمكانتك الأدبية أن تــُطبقَ على عنقها وتخمد أنفاسها!
المؤلف: الحق معك في هذه الجملة.
الرجل – الضفدع: وأنا . . ألم تنتبه إلى شخصي . . أنظرْ ماذا فعلتَ بي؟
المؤلف: ماذا بك أنتَ أيضاً؟ أرى رجلاً ذا عنقٍ طويل وفمٍ واسع وله عينان جاحظتان مكتنزتان بالمعنى والعمق.
الرجل – الضفدع: ألم تبصرني جيداً ؟ أنا كنتُ رفيقك في حربِ العصابات المأسوف على شبابها ، نزحفُ معاً ، ونقبلُ البنادقَ كحبِ أمٍ لأطفالها ، وكنا نهاجمُ معاً الصالونات الأدبية بالطماطم الخائسة والجملِ الملتهبة ، ونقدمُ الحارات الجائعةَ على أطباقٍ من لهب ، ونسحبُ شخوصَ العتالين وباعةَ الخضار المتنقلين والحمارين إلى قصورِ السادة وأفران المطابع ، ومخادع الملكات المتوجات بالعملة الصعبة ، فتجرجرنا الشرطةُ الثقافية وترمينا في الزنزانات والبلاعات الفائضة بالجثث المقتولة من أهل الحارة ، ويضعون في آذاننا الرصاصَ السائل فيطلع عصافيرَ وورداً ومنشورات.
ألا تتذكرني؟ أنا رفيقك في المطبعة ، وفي زقاقِ الهتاف ، رفيقك في الجوع الدائم ، حيث السنارات الممتدة في بحرٍ بخيل ، وحيث السرطانات تأكلُ أصابعَنا ، والأشباحُ تحرقُ أوراقَنا ، ألا تذكرني أنا الذي حميتُ ظهرك في البرد وفي الظلام.
المؤلف: وماذا بعد دوختني يا أخي؟!
الرجل – الضفدع: بعد كل هذه الرفقة النضالية العظيمة تحولني إلى آلةٍ حيوانية ، إلى حصالةٍ نقودية ، إلى نقنقةٍ ورقية، ليس لدي سوى أن أمضغَ الورقَ وأخرجه ، أمضغُ الورقَ وأحوله إلى ورق ، فأنا جالسٌ في بركةِ وحل واسعة ، وأنق ، أمد يدي وآخذُ النقود ، شحاذ مائيٌ ضفدعي ، الورقُ يطلعُ بلا توقف ولكلِ حرفٍ ثمن ، ولكلِ كلمةٍ شيك ، ولكلِ عبارةٍ سهم ، ولكل كتاب صك ، وأنا لا أشبع من الورق الذي لا يُشبّع ولا يُؤكّل ، جائعٌ دائماً ، معذبٌ للغذاء الطبيعي ، كلُ لوزة تتحول إلى ورقة ، وكلُ موزةٍ تغدو قرضةً ، وكلُ تمرةٍ تصيرُ غصة ، وكلُ قبلةٍ تصيرُ قرصةً، وآه من القرصات، فكلُ فقيرٍ يمر يقرصني ، وكل شاعر حقير يرفسني ، وكلُ كلبٍ ينبحُ يبولُ في البركة ويُظمئُني ، وأنا لا أتوقف عن النق، والدق والرتق للورق ، أحسبُ كلَ صفحةٍ سوف تصفحُ عني فإذا بها تصفعني ، وأرى كلَ بياضٍ كالسماءِ فإذا هو برصٌ يلبسُني.
فآه يا خالقي وصديقي وقاتلي كيف حولتني إلى ضفدع وأنا مشروع بلبل؟!
(يبكي فتظهر دموعٌ ورقية كثيرة) .
المؤلف: أنا . . أنا . . صدقني لا أعرف ، هذا هو سر الإبداع ، يأتيك من حيث لا تدري ، ويُشعلُكَ وأنت في عز الحر ، ويوقظك في عمق الليل ، ويطيحُ بعقلك ، ويفجرُ براكينك الخامدة . .
الرجل – الضفدع: لكن أنا . . أنا كنتُ فكرةً نارية ، أركبُ رصاصةً منطلقة إلى النجوم ثم أصيرُ دودةً في تفاحة عفنة ، كيف ؟ !
المؤلف: (يخاطبهُ هامساً وبحذر) لقد أعطيتكَ حريةً ، قلتُ لك تعلمْ ، تحركْ ، أخلقْ، أمشِ على الأرض الحقيقية بهضابها وحفرها ، أنا لم أُرد أن تكون آلةً بيدي ، بل شخصيةً من لحم ودم ، فرحتَ أنت تزحف على بطنك وتتلقى الركلات والعملات ، لا يهمك سوى إرضاء زوجتك التي لا تشبع من الفساتين والعشاق والرحلات وصرتَ حتى لا تشتهي أن تراها، عجّزت وقبحت وغدت ثرثارة مجنونة ، فاتسعت عيونك من البحلقة في التقارير والوجوه والأزقة ، واتسعت آذناك للصمت المرهف ، ونسيتَ حفيف الأشجار وموسيقى العصافير . . !
الرجل – الضفدع: أنا . . ألم تكن أنت الذي تسكتُ عن أخطائي ؟ ألم تكن أنت الذي أبتكر فكرةَ الحيلة ، وقلتَ أن الأدب حيلة، والفكر حيلة ، والشعر حيلة ، والزواج حيلة ، والحياة كلها حيلة ! وأنك من الممكن أن تعيش في مغارة اللصوص وقلبك مع علي بابا ، أن تأكلَ العيش الأصفر في قصر يزيد وروحك مع الحسين ؟ !
المؤلف : نعم قلتُ ذلك ، ولكن الحيلة التي لا تحولك إلى وحل ، وأن يجثم المقاوم الخفي داخلك ، وأن تظل أسلحتك فاتكةً رغم تراكم الغبار عليها ، وأن تعرف متى ترقصُ ومتى تقرص . .
الرجل – الضفدع: (مقاطعاً) ومتى تهرب ومتى تسكت والمذابح وسيول الدماء تنهمرُ حولك ومتى تختفي كفقاعة وتظهرُ كبالونٍ ملون في السماء ، ينفجر من قرصةِ ظفرِ طفلٍ ، حتى ظن الناسُ إنك شبح وكاتبٌ أجنبي مترجَّم . .
المؤلف: (منزعجاً) . . ! ؟
الرجل – الضفدع: تعلمتُ هذا منك بجدارة ، اختفيتُ ، تواريتُ ، توحلتُ ، متُ ، توحدتُ بالورق ، أنا كنتُ أيضاً أحتال، راكمتُ ورقَ البنكونت ، تحايلتُ ، مدحتُ الفئران والسعالي والكلاب وكلَ من يضع في جيبي ورقة ، ولم تكن تشتمني ، أو تريني شيئاً آخر ، تحتضنني ، تفتح ذراعيك لي ، تدعني أراقبُ الناسَ ، أكتب الورق عنهم ، حتى اتسعت عيناي وصارتا حفرتين من الرماد !
المؤلف : هذا اختيارك أنت ، ليس لي دخل بقراراتك وانهيارك ، كانت فيك خصالُ الضعف منذ البداية . .
الرجل – الضفدع: وأنت استغللتَ هذه الخصال ، استثمرتها ببشاعة ، تحايلتَ على روحي ، تعكزتَ على ضعفي ، فرحتَ بخلقي ، وتشوهاتي ، وتطوراتي ، التي حصرتها في جاذبيتك ، حاربتُ عنكَ حروباً لم تخضها ، وكل لحظةٍ أحاول فيها الخروج من ثيابك تعيدني إلى حصارك . . لم تجعلني مرةً واحدة أثور ، أخرج من البيت ومن سيطرة زوجتي وأهاجر ، لم تجعلني مرة واحدة أحتفي ببطل حقيقي . . (ملتفتاً إلى الشخصيات الأخرى) أنظرْ . . كل هذه الشخوص الآلية ، والمعطلة ، والمنسحقة ، والمنسحبة ، والمنفلشة ، كل هؤلاء المجانين ، وضاربي الودع والإبر، وأعضاء جمعيات الكيف . أنظر ْ . . هذا شخص يرتعش طوال الحياة ، يهتز بلا توقف ، به مسٌ كهربائي فلا هو يضيء ولا هو يحترق . . كلُ هؤلاء نتاج عقليتك العظيمة ، مملكةٌ كلها معطلةٌ من الفعل والخلق ، مجرد آلات تتحرك قليلاً ثم تتوقف، جذوع نخلٍ تمدُ سعفاتها اليابسات في الطرق وتتسول الرطب . .
وأنظرْ خاصةً إلى ذاك ، تعال يا سالم غانم !
الرجل – التابوت: إن مأساتي كبيرة يا صاحبي ، فقد بدأتُ حالماً كبيراً ، وكانت بي طاقة هائلة على الصدق والفعل ، لم توجد مظاهرة لم أشترك فيها ، غيرت الكثيرين من أهل حارتي ، الذين غدوا شجعاناً ، لكن هذا الرجل المؤلف بذر في نفسي بذرة سيئة ، لا أعرف كيف تسللت وانغرست ونمت حتى أكلتني فصرتُ من خشبٍ . إنها بذرةُ الكذب . يقول أكذب ، فعملنا يتطلب الكذب ، أعترف للشرطة فلا يهم ذلك ، والمهم أن تخرج مناضلاً نظيفاً ، المهم أن تصْدقَ مع رفاقك فقط ، قلْ للشرطة ما يحدث فلا يهمنا ذلك ، فرحتُ أكذب وأناضل وأعترف وتكدست الاعترافات ، وأناضل ، وأكذب ، أقبع في الزنازين وأخرج كأني لم أفعل خطأً ، أعود إلى أهل حارتي وأنا البطل المنتفخ ، وتنتشرُ القصائد والأغاني عني ، يصنعون لي تماثيل ، يجري الأطفالُ من طريقي إذا دخلت الزقاق ويقف الرجال ، وأنا محشو في داخلي بالتبن ، عملاق أسمر يسير في الشوارع كمارد ، ومرة واثنتين وعشر ، حتى اعتادت الزنازين على لحمي ، وتغذت طيورُ السجن من عظامي ، مات أهلي ، تشرد ربعي وهو يقول لي أكذب ! أدخلُ وأخرج والمنشار يحفر عقلي ، ويذيبُ لغتي وضميري وكلماتي ، هرب الناسُ مني ، ولم يعد لي أصدقاء ، وهو يقولُ لي أكذب ، اختفت المواعينُ والأسماك والطيورُ والقطط من بيتي ، وقبضاتُ الشرطة تدقُ الباب ، ورحتُ ارتعب ، أزحفُ تحت السرير ، وأرى الأحذيةَ القوية ، ويصدمُ رأسي بالجدار ، وأختفي في الدولاب ، اتغطى بالملابس ، أكتمُ أنفاسي وأنا أسمعهم يتقدمون لاعتقالي ، أكادُ أختنق من الحر والغازات ، وهم يتقدمون ، ويدقون على دولاب الثياب ويهمسون : أين القطة الحلوة؟ أين العفريت الصغير ؟مشيتُ ، تعريتُ ، تظاهرتُ بالجنون ، وهم لا يتركونني ، نزلتُ البحرَ عارياً وهم لا يتركونني ، وهو يقول لي أكذب ، حملتُ دولابَ الملابس فوق ظهري ، كلما سمعتُ صفارةً وضعته واختفيت فيه ، حتى حولته إلى تابوت!
الزوجة: ( لا تزال تمأ مىء وتضطرب ) . . آ . . آ . .م م م م . .!
الرجل – الضفدع: أزيحوا الستارة عن أسنانها قليلاً !
الزوجة: (وهي تنفجر) وأنا . . أنا لا تعطونني فرصة لأشرح خيبتي مع هذا الرجل، تزوجني وأنا وردة ، طفلةً تحبو على رمل الشعر ، كتب فيني أجمل الكلمات ثم حبسني في البيت ، ملأ المنزل بالعيال ، صرتُ آلة ، في كل سبعة شهور أنجب ولداً ، وهو يغيب كل ليلةٍ في الحانات ، وكل شهر في سفر ، ولقاءات دائمة مع المعجبين والمعجبات ، وتوقيع الكتب والقبل ، والجلسات مع أصدقاء الفكر والمزة والمعسل ، ثم صار عنيناً! . . .
الرجل – الضفدع: أغلقوا فمها ، فلا نريد فضائح عائلية .
المشهد الثالث
(تنطفئ الأنوارُ كليةً ، يحدثُ ظلامٌ دامس ، تظهر عينان مضيئتان ، تبصبصان في كل الاتجاهات ، يتحركُ الجسمُ الكثيف السواد في المكان ، تــُضاء الأنوارُ فجأة وتضبطُ الرجلَ – الفأر وهو يمسك مخطوطةً !
المرأة – الحية: من هذا ، أي حيوان غريب . . ؟
الرجل – الفأر: (وهو يرتعشُ) أنا حيوان . . يا بنت آوى . .
الرجل – الضفدع: ماذا تفعل يا كريم الآن ؟ أهذا عملٌ جديد لك ؟ !
الرجل – الفأر: (وهو مذعور) كلا ، كلا !
الرجل – الضفدع: ولكنني أرى عملاً جديداً لك ، لماذا تخاف ؟ أنت مبدعٌ كبير وصاحب إنجازات . . (يلتفتُ إلى المؤلف) هذا ضحية أخرى من ضحاياك ، كتلةٌ من الأعصاب المهتزة التي تعيش في الغيران ، هناك الضوء الشحيح لها ، هناك تخطُ كلماتها برعبٍ ، وهي تلتفتُ في كل لحظة ، مثل عصفور يحطُ من فوق جدار على سطحٍ مليءٍ بالأولادِ الأشقياء ، وهو شديد الجوع ولا توجد سوى كسرة خبز .. لكن العصفورَ يحطُ ويتلقى الحصى والبصاقَ ، ويخطفُ الكسرةَ ، ويعود العصفورُ فأراً في غاره ، جسدهُ دامٍ ، ويروحُ يخطُ ويتلفتُ ، يغرسُ كلمةً ، ويتلفتُ . .
(يتقدم نحوه) حدثنا عن تجربتك يا كريم ، قلْ قصتك مع المؤلف . .
الرجل – الفأر: أنا أتحدث ؟ أقول قصتي . . ؟ ما هذا الهراء ! أنا ليست لي أي قصة ، أنا مواطن مسالم ، لا أتعدى إشارات المرور ، أذهب إلى عملي بانتظام ، كل رؤسائي يشكرونني ، لا أكتب أي شيء ، أنام منذ الساعة التاسعة ، ولا أحلم ، لا أشارك في العرائض . .
الرجل – الضفدع: لا أحد غريب هنا يا كريم ، فأنظرْ إلى هذا الرجل ، ألا تعرفه ؟ ألا تشعرُ بشيءٍ تجاهه ؟
الرجل – الفأر: (يحدقُ بخوفٍ وكره نحو المؤلف ويدمدم !) .
الرجل – الضفدع: هيا دعْ روحك تنطلق . خففوا الأضواء يا سادة ، ركزوا عليه وكأنه يعيش في غاره وحيداً ، وليطلق شحناته الكهربائية!
الرجل – الفأر: كنا صديقين حميمين ، كان يشعر تجاهي دون مخلوقاته الأخرى بودٍ عميق ، كان يحضرُ إليّ في قلبِ حارتنا المليئة بالصغار الشياطين ، لنناقش فوق السطح كيفيةَ الاستيلاء على المدينة ، وكيف نحررُ خزائنَ البنوك من الأنانية والوحدة ، كان يعطيني بعضَ المنشورات لأوزعها في الحارة ، وهو يعرفُ إنني أموتُ من الخوف ، وبعد أن أُلقي بضعَ أوراق في مزبلةٍ أو فوق جدارٍ وأهرب هرباً سريعاً ، أتجمدُ على سريري وأتقلب ، كلُ دقةٍ أحسبها قدوماً للشرطة ، وكل نفخة هواء أظنها هجوماً عسكرياً ، ومرةً كنت أمشي في ممر مظلمٍ وأردتُ أن أسربَ منشوراً من شقِ نافذةٍ خشبية قديمة ، فإذا بها تــُفتح وأرى رجلاً ذا وجه ضخم وشوارب بحجم مكنسة هائلة ، تجمدتُ برعب وحركت المنشور قليلاً قليلاً حتى أدخلته في فمه المفتوح ، وبعدئذ تبخرتُ . .
المؤلف : هذه واقعة لم أعرفها من قبل . . كيف تخفي عني الوقائع هكذا؟
الرجل – الفأر: كنتُ أرتعش في حضوره ، أكاد أنطقُ بالكلمات وأصيحُ : يا سيدي أنا رجلٌ جبان ، لكن حين أراه وأسمع كلماته أقطع شريطي الداخلي . يقولُ : لا تخفْ أبداً ، الشجاعة لم تــُصنع معنا منذ طفولتنا ، بل نصنعها نحن بمواقفنا الصغيرة المتراكمة ، تنمو معنا ، مع ازديادِ غضبنا وتساؤلاتنا وتحدياتنا ، تتشكلُ بين الجدران وفي الظلام وفي التعذيب وفي الحب وفي الإيمان ، شجاعتنا تزدهرُ مع لغتنا ، مع الضوءِ الذي نتوجه إليه ، مع المستقبلِ الذي نخرجهُ من الأفق كشمسٍ كبيرة عظيمة . مع الأطفال الذين ندافع عن حليبهم غير الملوث. كنتُ أحبُ هذه الكلمات، كنتُ أتطلعُ إليه مبهوراً .
وذاتَ يومٍ قال لي: لك موعد تجريبي مع الشجاعة . اليوم ستولدُ . ووضعَ في يدي كيساً . أرتجفتُ . لكنني تماسكتُ . قال: هذه قنبلة ، أضربْ مركزاً للأعداء! ارتعبتُ ، كدتُ أموت ُ ، صعقتُ . . نمت . . صحوتُ . . شرقتُ بالماء . . تنبهتُ إلى موعد إلقاء القنبلة . . تنملَّ جسمي ، مددتُ يدي إلى الكيس ، لم أجده ، فرحتُ ، لكنني وجدتُ أكياساً عدة تحت سريري ، تحسستها ، أخذتُ واحداً وأنا أهتز ، وضعتُ قدمي في نعلِ أمي ، سرتُ ، أتذكر كلماته وهي تدفعني : الشجاعة تعلمٌ وموقفٌ وتراكم نفسي ، أضيعُ بين الأزقة ، أجدُ الخبازَ أمامي لا مركز الشرطة ، يسألني الخباز : ماذا تريد يا كريم ؟ ألم تأخذ أمك الخبز قبل قليل ؟ ! فأقول : بل أريدُ زجاجةً من هذه العجائن الفارسية البحرية الشهية ، فيناولني زجاجة تضاف إلى زجاجتي، فأتخيلُ نفسي أسبحُ في بحرٍ واسع عميق وأنا مرفوع بعدة زجاجات فارغة، والموجُ يتلاطمُ حولي ..
وأخيراً وجدتُ مركز الشرطة أمامي ، والظلام يلفهُ ، ولا توجد سوى هسهسة الجنادب ، ووأوأة العصافير النائمة ، وصحتُ في نفسي: لتكن الشجاعة اليوم وليس غداً! وألقيتُ الزجاجةَ التي انفجرت وأصدرت روائح رهيبة ، وتراكض الناس ورائي وهم يسدون أنوفهم ، حتى ألقوا القبض علي . .
تخشبتُ في الزنزانة ، جثمتُ أياماً لا أتحرك ، لا أشرب ، لا أتبول ، لا أعرف ، اعترفتُ ، كتبتُ كلاماً كثيراً يملأ غرفةً، منذ أن ولدتني أمي ، كيف سرقتُ أول فلس ، كيف نظرتُ لبنتِ الجيران ، كيف ضربني المعلم ، كيف كنتُ أتبول في فراشي وضربات أمي ، وعجزي عن ملامسة أي امرأة ، وحبي للظلام ، ولكني لم أتكلم عنه ، عن معلمي الكبير ، أخفيته في ظلمات خوفي ، أحسستُ إنني أقوم هنا بفعلٍ عظيم ، رغم إنني وُضعتُ في قبرٍ لمدىً طويل ، وفي كلِ تلك اللحظات الطويلة المرهقة لم يسأل عني أبداً . .
المؤلف: كيف أسألُ عنك ، أين ضوابط العمل السري؟!
الرجل – الفأر: خرجتُ متهدماً ، كلُ ظلٍ أعتبره شرطياً ، كلُ نأمةٍ أحسبها كبسة ، أكتبُ ، أكتبُ كثيراً ، ولا أعرف ماذا أقول أخفي أفكاري عن أفكاري ، وألاحظ عيني وهي تراقبُ رأسي ، رِجْلٌ تمشي في اليمين ورجل تمشي في اليسار ، عدة أشخاص يتصادمون في جسمي ، أنا ثائرٌ على الثوريين ، صاخبٌ على النائمين ، في هذه اللحظة وأنا حطام ، أجثم في غرفة فيها بعض الضوء ، جاءني وقال : دعنا من الماضي ، إن الثوريين لا ييأسون ، بعد فشل الثورة العاشرة يفكرون بالثورة العشرين ، فصرختُ فيه : أنا بعد سنين من السجن لم يبق لي شيء ، لا أعرف عملاً ، ولا مدخرات لي، وبيت الأهل القديم بعته وسددتُ ديوني ، وليس لي سوى هذه اليد تكتب ، هذه العروق الأخيرة تتحدى الجوعَ والظلام والحزن! فقال: لندعها تكتب ، لندعها تستغل إمكانياتها ، أكتب وأعطني وأنا أنشر . . أجبته: لكنني لا أكتب . . قال: أحضرْ خربشاتك وأنا أعدلها . لا تخفْ! صحتُ : ليس ليّ خربشات! أعطيته وورقي ، وصار يظهرُ باسمه ، وانتظر نقودي بلا فائدة ، اتصل به فيقول ليس لديك حتى الآن حساب في البنك ، ويضيف : أين القصة التي وعدتني بها؟ يحضر رجلٌ من الوطاويط ، يدقُ على باب غرفتي ، يقول : ماذا تفعل يا كريم ، أتكتب ، ماذا تكتب؟ أجيب: أقسم بالله العلي العظيم إنني لا أكتب . تتسللُ يداه إلى ثيابي ، فيظهرُ ورقٌ ، تتسللُ إلى جلدي فتقفز قصةٌ ، أختبئ تحت السرير فأرى وطواطاً مسترخياً يبصُ في عيني ، أحفرُ في الجدار ، أصنعُ سرداباً ، أحفرُ الكلمات: فيأتيني صوتُ المؤلف الذي لا يؤلف: ماذا تفعل عندك يا كريم؟!
الرجل – الضفدع: والآن نقدمُ لكم الضحية الأخيرة المعاكسة ، المرأة – البالون!
المرأة – البالون: (حين تتقدم تنفجرُ بالوناتٌ عدة) أيها الحضور الكريم يطيبُ لي أن أتقدم مدافعةً عن هذا الكاتب المغبون، الرجل الذي وقف مع النساء دائماً ، فأنا على سبيل المثال لا الحصر ، كنتٌ كاتبةٌ غضة ، مبتدئة ، لا اعرف شيئاً من فنون الكتابة ، فأخذ بيدي على سلمِ المجد ، قدمني إلى الصحافة والتلفزيون ، كتبَ نقداً بناءً عن أشعاري ، عرضوني في الندوات، طبعوا لي طبعات فاخرة ، نلتُ جوائز كبيرة ، عملتُ مقابلةً مع أمرئ القيس ، ومقابلةً مع أبي نواس رغم أنه لم يكن مهتماً بي كثيراً دون أن أعرف الأسباب ، حين أذهب إلى المهرجانات الجميع يلتفُ حولي ، صار الكثير من النقاد يكتبُ عني ، وأنا أقول إنني لا أستحق كل هذا المديح ، فأنا امرأة موضوعية عصرية ، صحيح إن جمالي وأنوثتي البارزة تلعبان دوراً كبيراً في ذلك ، لكنني أوجهُ النقادَ إلى الاهتمام بالجانب الفني الحقيقي ، وأنه من الضروري أن يبتعدوا عن المؤثرات الشخصية ، حتى جاء أحدُ المسعورين الحاقدين وزعم إن ما أكتبه ليس سوى هراء نثري ، ورفع قضية على المجلس الثقافي لدينا لكثرة إرسالي ضمن الوفود الثقافية ، وترشيحي لأكبر جائزة أدبية دولية ، ولطباعة كتبي العديدة ، وجعلي سفيرة دائمة للثقافة ومندوبة الدولة الفكرية في الأمم المتحدة ، لكن كل هذه الحملة المسعورة من الناقد المذكور ، (والسبب إن زوجته شمطاء ، وعبرَّ لي مراراً عن وده ، لكنني لم أعطه وجهاً) ، لم تستطع النيل مني ، بفضل هذا المؤلف العظيم الماثل أمامكم ظلماً ، فهو الذي تقدم للدفاع عني ، بعد أن راح يصنع المقدمات الجميلة لدواويني ويفاتحني بنقد مسبق حولها ، فصرتُ أتقدم بشكل مهول ، وأخرسُ كلَ الألسنة الحاقدة!
المؤلف: (يصفقُ بحماس . . لوحده) .
المشهد الرابع
(الصالة المنزلية تتحول إلى قاعة محكمة يرأسها أحدُ الأشخاص الجدد ، والمؤلف في القفص ، وثمة حضور من الكائنات المزدوجة: الرجل – الضفدع ، المرأة – الحية ، وأشكال أخرى متعددة من هذه المركبات البشرية – الحيوانية، وثمة لغط وانتظار وتحفز.) .
القاضي: لقد أعطي المؤلف فرصة للدفاع عن نفسه فحضر أحد أهم الكتاب الباحثين للقيام بهذه المهمة .
الناقد – الثعلب: لقد كانت كلُ الوقائع الاتهامية المقدمة عاجزةً عن التفريق بين الإبداع والحقيقة ، فالإبداع لا علاقة له بالحقائق والوقائع الدقيقة في الحياة ، بل هو خيالٌ والمؤلف يصور ما يجري ، وليس هو مسئول عن كون الشخصيات في الحياة كلها ساقطة ومبتذلة ومائعة أخلاقياً ، لقد انهار الناسُ وتدمروا ، والمؤلف الصادق مع نفسه يلتقطُ ما يجري فيهم ويصوره ، هل يخلقُ بشراً من الفراغ؟!
ولأكن صادقاً معكم فأنا نفسي كنتُ مخلوقاً من مخلوقاته الاجتماعية والفنية ، كنتُ أعيش في حارة مكتظةً بالناس ، نهاجمُ ساحلَ البحر ونأكلُ السمكَ الصغير والقواقعَ والمحار وأسماك القرش ، وكنا كلنا في ذاك الوقت مناضلين ، أشداء، وكان المؤلف يزورنا في بيتنا المتداعي ، ويلمحُ فيني بذور النقد ، فأنا لا أبقي نقداً عند أحد ، فكنتُ أهاجمُ الخبازين وأسرقُ نقودَهم الصغيرةَ ، وأخدعُ الشحاذين القلائلَ الذين يمرون في الحارةِ فأقودهم إلى بيوت خالية وأهجم عليهم ، وكان الرفاق يقيمون ليّ محاكمة على الساحل الواسع في ذلك الحين ، فكنتُ أدافعُ عن نفسي بخطب جعلت المؤلفَ يعجبُ من سحر بياني.
ومن ذلك الوقت أخذ يوظفني في تقريض أعماله ، فحين كانت تظهر له قصصه الأولى في الصحافة ، كنتُ أسارعُ بنقدها، فأشرشحها شرشحة مرة ، وبطبيعة الحال من خلال اسم غير اسمي ، ويكون لهذه المقالات صدى مدوٍ ، لأنها كـُتبت بطريقة النقد الذاتي الضعيف المهلهل ، ثم أقوم بعد عدة أيام بالرد على نفسي ، ومن خلال اسمي هذه المرة ، وعبر النقد الرزين فاكشفُ الأخطاءَ الكبيرة التي تعمدتُ بناءها ، ليصمت ذلك الناقد إلى الأبد ، ويختفي كفقاعة.
وبعدئذٍ يكون للمؤلف صيته الواسع! كما تكون لي دعوة على سهرة عامرة وأشياء أخرى.
بطبيعة الحال لم تعجبني دعوة المؤلف لحرب العصابات ، خاصة أنها واكبت ظروفاً غير مؤاتية ، فكنتُ موظفاً متطلعاً إلى منصب مهم في الوزارة ، كما أن جبالنا كلها أشبه بتلالٍ تافهة ، لا توجدُ فيها مغارات ، ولهذا فقد قطعتُ الخيوطَ مع كتاباته وسيرته ، في الظاهر ، أما في الباطن فكنتُ أعلن حبي له خاصة لأصدقائه المقربين جداً . وأقول لعله يكون له شأن في يوم من الأيام، فلماذا أعاديه؟ خاصةً إن حبي له لا يمنع كتابة أطروحة الدكتوراه عن شعراء المجون في العصر العباسي.
وبعد أن خرج ، وأحتل موقعه في الوزارة ، تغير نقدي من الاهتمام بالشعر إلى الاهتمام بالنثر ، ومن قضايا المجون إلى قضايا الثورة ، وهو لم يبخل علي بإهداء مجموعاته وكتابة إهداءات شعرية حميمة ، وحينئذٍ في الواقع رأيتُ موهبة فذةً صقلتها معاناة التجربة المؤلمة ، وأنضجتها نوافذُ الانفتاح والإطلاع.
سيدي القاضي هنا كان عليه أن يعري الحياة التي رآها ، وتلك الشخصيات المحبطة المهزومة التافهة ، هي نتاج خياراتها ، نتاج بذور الضعف مثلي أنا ، الذي أعترف بأنني كنتُ ضعيفاً ، ونفس المؤلف صورني وعراني فغسلني .
بطبيعة الحال لديه عادة خاطئة كبيرة ولا تغتفر لكنه بشر . وأضربُ مثالاً واحداً وهو إنه يقرأ النقد أولاً وقبل النشر ، ويصحح فيه ، وعدة مرات كتبه بنفسه ، وأحياناً يلكمني بقسوة نظراً لبعض الهفوات . لكن كان كريماً ففي كل ندوة وفي كل سفرة كنتُ أحد المدعوين.
القاضي: في الواقع إن كل مزاعم الشخصيات بجناية المؤلف تعتبر باطلة حسب قوانين النقد والإبداع ، ولهذا أنا لا أجد أمامي متهماً ولا قضية!
الرجل – الضفدع: ما هذا الحكم ، هذه مؤامرة! إن في الحياة نماذج فذة ، مثلي أنا الذي تم تشويهي بشكل صارخ ، ولم يقم النقاد المأجورون بفضح ذلك ، بل كانت تقام حفلات ودعوات سفر فيكتبون تقريضاً عظيماً لقبحنا وتفاهتنا ، وربما يكون حتى هذا القاضي مؤامرة مدبرة من وزارة الإعدام!
القاضي: يجب أن تتحلوا بالصبر والشجاعة لتعترفوا بأنكم كنتم شخصيات متعفنة بشكل موضوعي ، خائسة منذ طفولتها، ولم يفعل المؤلف شيئاً سوى أن ترك لها مجال التبرعم والأزهار الشرير.
المرأة – الحية: أتعرفون من هو هذا القاضي أنه بطل قصته (الحصان) الذي حكم المدينة وأخرس أصواتها ، وراح يسربُ النملَ والضفادعَ إلى الأسواق والمنابر!
القاضي: أسكتِ أيتها الشريرة ، سوف أطلق عليكم النار جميعاً!
الشخصيات كلها تندفع بذيولها وخزاناتها ووطاويطها وصرخاتها نحو المؤلف لتخنقه وتتحول إلى زهر وعصافير ونوارس تنطلق في كل اتجاهات المسرح.
البائع والكلب – قصة قصيرة
 كتب : عبـــــــدالله خلــــــــيفة
كتب : عبـــــــدالله خلــــــــيفة اختفت النجوم تحت وطأة غيوم سوداء، أما القمر فلم يظهر منذ عدة أيام. الأشجار امتدت على طول الطريق، وقفت بمهابة وانحنى بعضها يحكي قصة الموت والمطر.
أما أنت فقد كرهت أن تختفي النجوم، ويغيب القمر ورحت تقود السيارة بلا مبالاة تجاه الأضواء والأشجار التي وقفت كشحاذين يمدون أيديهم للمارة.
ها قد وصلت الى المنزل وانتهى الشارع. المكان هادئ الا من ضجة خافتة تتسلل من مبنى النادي. وأصوات قادمة من حي الاكواخ والسراديب تنبئ عن ضجة لصوص اختلفوا حول الغنيمة أو مشاجرات عائلية استخدمت فيها السكاكين.
ولكن أين البائع هذا الرجل الذي يطاردك أينما ذهبت. ليس بعيداً أن يكون أحد هؤلاء المشاغبين الذين ينتظرون الفرصة السانحة للفتك بك.
ها هو يجلس قرب الجدار وقد التصق بعربته وارتدى معطفاً شتوياً خاض الدهر عليه حروباً تكللت بالظفر. انه يدخن باستمرار، ولعله في هذه اللحظة عينها يفكر في إشعال الفتيل.
أليس غريباً أن يلازمك عدة شهور دون أن يتكرم بالتعرف عليك وجها لوجه وأنت أيضاً لم تتشرف بدعوته للعشاء على مائدتك.
أوقف السيارة وتناول المسدس. أمسكه جيداً لئلا يفلت من يدك. أنت لا تجيد إطلاق النار ولكن الدفاع عن النفس يعمل المستحيل. من يمكن أن يشترى منه هنا؟ بعض رواد النادي، والمارة الذين ألقاهم القدر في طريقه. إنهم يعدون على الأصابع.
انه يلتفت إليك ببلاهة. يتظاهر بعدم معرفتك. كذلك لم تحلم به. كأنه لم يحاول شنقك تلك الليلة.
لديه مصباح صغير يضيء قليلا. ولا يستبعد أن تكون القنبلة بين البضائع تنتظر الزبون المنتقى بعناية.
ــ هل لديك علبة تبغ من طراز . . .
ــ نعم.
ترك مقعده وأعطاك العلبة. آه أليس عجيباً أن تكتشف أن البائع لا يملك سوى يد واحدة والغريب أنه شاب يافع، وليس عجوزاً عتيقاً كما تصورته.
ما هذا؟ كاد أن يقتلك خوفاً هذا الكلب. كلب لا تعرف من أين طلع، أبيض واسود. هزيل راح يتشممك بانتباه، ثم تطلع إليك باستغراب. وأوشك على النطق لولا أنه أحجم في اللحظة الاخيرة، وابتعد عنك. جلس تحت قدمي البائع وأن أنه طويلة وهتف بحرقة «ما أقسى الأيام !»
ــ يبدو أن البيع معدوم هنا ؟
ــ ابداً يا استاذ، البيع جيد.
أغفى الليل اغفاءة طويلة. ومشت السحب تغطيه حتى قدميه الممتدتين في الأفق. وفي لحظة شع برق خافت كأن أزرار سترته سقط.
ــ أظنها مهنة صعبة، بيع مستمر حتى في ليالي الشتاء القارسة و . .
ــ بكل تأكيد، ولكنها ليست أقسى من مهنتي السابقة.
انفتحت شهيته للحديث. لن تكون مخطئاً في دعوته الى حفل مندوبي الشركات.
ــ كنت عاملاً في مصهر الحديد . .
هذا أحد مشاريع وزارتك. ألم تسيء في تصور الشاب مخبراً وجلاداً ؟
قام الكلب وراح يتثاءب. ثم هز رأسه بخبث وطلب سندويتشاً من أحد المطاعم. لكن البائع تجاهل طلبه.
ــ كنا نشتغل عشرين ساعة في بعض الاحيان، النوم والراحة لا نجدهما . .
هل حضرت من أجل سماع هذه الكلمات ؟ انتظر قليلا سيكشف الشاب عن وجهه البشع.
ــ الحرارة، الموت، البؤس، كلها غنت اغنية واحدة وأثمرت الضحايا. .
ماذا تسمع؟ كلام مزعج، ابتعد، ادخل منزلك، التحف، احلم بالهدوء والحب. لكن حلمك الان حرائق تشتعل في بدنك. جموع غفيرة ذات أعلام كالدم تزرع الانفجارات والضحايا. اسكت، اسكت !
ــ أنا لم أفقد سوى ساعدي الايمن. آلة كلها أسنان أخذته بعنف.
الكلب يتثاءب ثانية، يقترب من مدخل العربة ويشم طويلا. قال «هنا لحم، وأنا جائع جداً وعوضاً عن الأكل نسمع ثرثرة مملة».
ــ أنت وأمثالك تبنون حياتنا الجديدة . .
ــ هل عملت مدرسا يا أستاذ. .؟
أنت تتحمل نتائج نزولك الى القاعدة الشعبية. ينبش البائع ماضيك ثم يقدمك لحماً مشويا لكلبه.
ــ نعم، حدث ذلك منذ سنين بعيدة.
ــ ألا تذكرني؟
طالعت وجهه بدقة أكبر. غص في الوحل وتذكر التفاهات.
ــ للأسف.
ــ كنت مدرسنا.
ــ لا أذكر.
ــ أعطيتنا كتباً.
ــ لم أتعامل بالكتب مع الطلبة.
ــ فيها كلمات رائعة عن الإنسان والوطن . .
ــ الكلمات لا تجدي، والانسان آلة لولا العمل والمال.
ــ حدثتنا طويلا عن البؤس . .
ــ لا أتذكر شيئاً، يبدو أنك تتحدث عن مدرس آخر.
ــ وفي يوم اختفيت . .
ــ واقعة حقيقية، وبعدها عرفت الطريق . .
ــ جئت الينا ثانية ولم تتحدث بشيء، وحينئذ . .
ــ تفتحت لي الدنيا.
ــ ولكنني أحببت ما تقول وعملت كثيراً من أجل الوطن . .
ــ هذا رائع.
ــ وحين عملت من أجل الوطن انتزعوا ذراعي فتركتني حبيبتي . .
ــ في سبيل الخدمة العامة تهون التضحيات.
ــ بحثت عن عمل فلم أجد.
ــ أمر مؤسف.
ــ أما التعويض فلم أحصل عليه.
ــ أخطاء ادارية تحدث دائماً.
ــ والجوع يلاحقني أينما أذهب . .
ــ حاجة بيولوجية حتمية.
سكت الشاب لكن فمه ظل يتحرك ـ كأنه تحدث للكلب عن المهزلة بصورة سرية. لكن الكلب كان يتطلع إليه لشيء آخر. وقال بلهجة ساخرة «وما فائدة هذا الحديث الغريب ؟ الافضل ان نأكل». هذا البائع خطير، يتكلم بصورة مزعجة. ويؤمن بآراء تسبب الضرر. أما مراقبته لك وتخطيطه لقتلك فمسألة لا تحتاج الى تحقيق.
السكون تجول في الفضاء طويلا. قبل البحر البعيد، وعانق الغيوم ثم نزل الى المدينة وراح يتجول في الشوارع. لم يصفر. لم يدخن. بل ظل يرمق البيوت والاشجار باستياء بالغ.
ــ ضحايا التقدم كثيرون.
ــ الجوع . . الجوع
قام البائع فجأة وسحب كيساً. أخرج سكيناً من جيبه الواسع. ها هي صرخات جموع الفقراء تأتي هادرة فتطيح بالبيوت الشامخة وتشعل الحريق في المتاجر والمخازن. عينا البائع استحالتا إلى كشافين ساطعين وأطلقتا سلسلة من البيانات الثورية. نصل السكن يلمع. الكلب يقفز فرحاً. تناولت مسدسك بسرعة مخيفة. أطلقت رصاصة مدوية استقرت في صدره. تهاوى ببطء. امسك العربة. جحظت عيناه سقطت السكن. سقط الكيس. تحشرجت الألفاظ في فمه. تناثر البصل والارغفة.
ــ ايه ماذا أفعل ؟
سمع ضحكات غريبة فعرف انها الأشجار استثارها الموقف. لم ينتبه أحد غيرها. أما الكلب فتطلع بدهشة إلى صاحبه. وحين رأى الكيس اندفع إليه وأدخل رأسه فيه، ومالبث أن أخرج كمية من الكباب المشوى. وقبل أن يلتهمها. نادى صاحبه الى العشاء فلم يلبي الدعوة، لهذا تخلى عن مشروعه وحاول أن يوقظ البائع.
هيا ابتعد عن هذا المكان المريب، اتصل هاتفيا بالشرطة وأخبرها عن محاولة لاغتيالك وتنتهي المشكلة.
دخل إلى منزله متشائماً. وبقى الكلب ينادي صاحبه بعنف. ثم راح يئن ويبكي بحرقة. وما لبث المطر أن هطل بشدة على الرصيف.
كتابات | سجن جدة
01 أكتوبر 1976

باب البحر «قصص» دار نينوى للدراسات والنشر 2020.
❖ «القصص: وراء البحر.. – كل شيء ليس على ما يرام – قمرٌ فوق دمشق – الحب هو الحب – شجرة في بيت الجيران – المذبحة – إجازة نصف يوم – حادث – البائع والكلب – ماذا تبغين ايتها الكآبة؟ – إمرأة – الربان – إذا أردتَ أن تكونَ حماراً – اللوحة الأخيرة – شاعرُ الصراف الآلي – البيت – حوت – أطروحةٌ – ملكة الشاشة – الغولة – وسواسٌ – مقامة المسرح – إعدام مؤلف – يقظة غريبة».
April 18, 2023
إذا أردتَ أن تكونَ حماراً ــ قصة قصيرة
(1)
– يا سيدي ليس سهلاً أن ترتقي إلى مكانة الحمير ، فلا تصدع رأسي !
– ولكنني من قبيلة عربية عريقة اسمها قبيلة جحش ولنا نسب معكم وطيد !
– بعد الثورة المباركة التي قام بها القائد سقراط لم يعد ثمة قبيلة عريقة وأسر فوق البشر والحمير !
– وكيف انضم إلى الإدارة إذن ؟
– يلزمك ورقة دمغة أولاً لتكتب عليها مؤهلاتك التي سيجري إختبار عليها .
– وكم يستغرق ذلك ؟
– ثلاثة أيام بشرط أن تكون مؤهلاتك حقيقية .
– وإذا لم تكن حقيقية ؟
– هناك معسكر العقاب !
مشى مضر بعيداً . كانت السيارات الفارهة تقودها وجوهٌ حيوانية بشعة . آذان طويلة . أنوفٌ مروعة ذات مناخير مفتوحة على اتساعها وكأنها فوهات خباز ، وبعضها يضع نظارات سوداء ، ويبدو معجباً بنفسه !
فلل الحمير في البرية المرتفعة ، بيوتٌ ضخمة تحيط بها حدائقٌ غناء ، نوافير عالية للمياه ، ويرفعون إعلانات تدعو إلى عدم التفريط في الماء ! الماء ثروة حمير فحافظوا عليه !
يندسُ في زقاق ضيق . هنا حشود البشر ، قماماتٌ لا أول لها ولا آخر ، أولادٌ يلبسون خرقاً ، شيوخ يجلسون على دكات الأبواب ويمضغون التبغ واللبان وحشائشَ غامضة ويبصقون بصقات كبيرة حمراء مروعة . وفي كلِ خطوةٍ من خطواته تنشب معركة ، ويُقذف شخصٌ ما من طابق أعلى ، أو يندفعُ آخر بدراجته النارية مطيحاً بالسلال والبراميل ، والصراخ لا يتوقف ، والجدلُ يندلعُ بقوةٍ ويَسمع :
– يا سيدي العرب من سلالة عدنان وعمروا الأرض من الصين حتى جمهورية نيجيريا الشعبية !
– بل من سلالة قحطان وأشادوا السدود وأبراج بابل وصعدوا للسماء بأجنحة من ريش . .
– هذا تلميحٌ فظ ودنيءٌ تحقيري للدين ولا اسمح به مطلقاً !
– ألم يصعد أحدهم بريش طيور وضربه نسرٌ في عينه فسقط على أم رأسه ؟ أتجادل في هذه المعلومات الأولية المتواضعة ؟
– لمَ نتجادل هنا ولا نذهب للمقهى ؟
– منعَ الحميرُ المقاهيَّ منذ فترة يا هذا ، أين أنت ؟
– لماذا منعوها ؟!
– يقولون بأن البشر يكثرون من الثرثرة وأن المقاهي تحولتْ إلى بؤر لأمراضٍ خطيرة ولكن السبب الحقيقي هو منع التجمعات !
– إذن نذهب للخمارة .
– من أين النقود ؟ كما أنهم رفعوا أسعارها كثيراً حتى اقتصر شربها عليهم !
مشى مضر بعيداً عنهما . منذ أن تفتحت عيناه وهما يتجادلان عمار وعمير ، منذ الصباح الباكر ، يدخنان ، ويقرآن الصفحة الرياضية من جريدة صوت (الأمة الحميرية) . وقد يذهب عمير إلى بيت عمار ناسياً ، ولا تعرف زوجة عمار وعياله بأنه عمير وليس عماراً ، وتصحبهُ للفراش وتعطيهِ الغداءَ ، في حين يذهب عمار إلى بيت عمير ويحدث مثل ذلك ، ويتداخل الأطفال والصبية وتندلع الشجارات ويختلط كلُ شيءٍ ، خاصة أن عمير وعمار يعيشان في خرابة واحدة .
وصلَ مضر إلى منزله . اندفع الأطفالُ إلى ساقيه يفتشان جيوبه ، ووجدوا بضع لوزات تشاجروا عليها . ولم تعمل زوجته الغداء قائلة بأن السمكة التي احضرها أكلتها القطة .
ترنحَ على سريره وتطلع إلى التلفزيون المثرثر عن الانجازات الهائلة التي حدثت بفضل الثورة المباركة .
– التلفزيون مفتوح يا امرأة وكل هذا يضيف مبالغ على الفاتورة المتضخمة أصلاً والتي لم تــُدفع منذ ثلاثة شهور ! لو كنتُ أحكي مع غنمة لفهمت !
– قالت الجارات بأن ثمة برنامجاً مهماً سوف يُذاع .
– أي برنامج هذا الذي يستدعي فتح القنوات على الهواء ؟
– الأطفال يتفرجون يا هذا ؟ !
– على ماذا يتفرجون ؟ لقد منعوا أفلام الكارتون ، وصلت الغرامات على من يشاهد توم وجيري مائة دولار ، أما كارتون (حماري قال لي) فعقوبته الحبس ثلاث سنوات !
– الله يجازيهم !
– إذن ما هذا البرناج الذي يستدعي كل هذه الهدر في الثروة الوطنية ؟
– أطمئن بمناسبة هذا الخطاب أُعتبرت الكهرباء مجانية طوال هذا اليوم .
– يا لسعدنا !
– وماذا فعلت مع الشغل ؟ هل ستظل هكذا عاطلاً معتمداً على الإعانات وسرقة حظور السمك ليلاً ؟
– لم أجد سوى أن أقدم طلباً للانضمام إلى مجتمع الحمير !
تركتْ زوجتهُ تقطيعَ البصلِ وحدقتْ فيه بعينين دامعتين :
– هل تفعلها وتخون أهلك وقضيتك التي كافحت من أجلها سنين طوالاً ؟ ماذا أقول لأهلي وسكان الحي ؟
– أي قضية يا امرأة ؟ من بقى ؟ من صمد ؟ اندثر كثيرٌ من العرب وتولى الحكمَ في أغلب البقاع الحميرُ وبعضُ قرودِ الجبال . وحتى سكان الصين والهند رحلوا إلى المريخ وعطارد ، ولم يبق سوانا على هذه المعمورة التافهة .
– قلتُ لك أن تتعلم على هذه الأجهزة فتكتب وترسل مقالاتك إلى جريدة المريخ الأولى وأنت مصرٌ على حفظ وأعراب الشعر الجاهلي ؟!
– أنا الخبير الوحيد الآن في الشعر الجاهلي يا امرأة ، الكثير من العلماء اندثروا وأخاف أن أُقتل فتضيعُ لغتـُنا إلى الأبد . .
– وهل سترضى بك لجنة فحصِ الحمير . . أغلب سكان الحي فشلوا . تذكرتُ الآن . . سيكون الخطاب لسقراط زعيم الحمير وسيلعن عن إجراءات لتطوير حياة العربان .
وبعد أغان حماسية ملتهبة ، ظهرت جماهير كبيرة من الحمير تلوح بالأعلام الوطنية ، ثم توجهت الكاميرا لقاعةٍ كبيرة ، ظهر الحميرُ فيها ببدلاتٍ أنيقة ، وجثموا على أرضيةٍ مفروشة بالبرسيم المقطوع ، لكنهم كانوا متصلبين ولا يقومون بقضم ما بأسنانهم الضخمة ، ثم وثبوا نهوضاً حين دخل الزعيم ببدلته المميزة ونظارته الطبية السميكة . قال الزعيمُ وقد تحلق حول التلفزيون الأولادُ وأمُهُم وراحوا يأكلون بشراهة :
– لقد ازعجونا العرب كثيراً بتخلفهم ورفضهم برامج تطوير حياتهم ، وقاموا بشغب خطير خلال اشهور الماضية ، وتعطلت مصالح خاصة عملية غزو كوكب الزهرة الصعبة والمكلفة للأسباب العملية التي شرحتها لكم في مناسبات سابقة ، ومع هذا فسوف نتغاضى عن تخريبهم وحرقهم لبعض المصالح الحيوية ونقدم تنازلات ونوافق على جوانب من نمط عيشهم ، فسوف يُضاف إلى رمضان شهر آخر للصيام ، بشرط منع السهر إلى الفجر ، من أجل أن لا يتلاعبوا بالزمن ، كما أن حفظ الشعر سوف يُعاد في بعض المدارس العامة ، وسوف يُسمح بأن تنجب المرأة أكثر من عشرة أطفال ، ويُسمح بعودة تدخين الشيشة في بعض المقاهي وأن يـُلقى النقوط في بعض الملاهي على أن لا يتم التنقيط على الراقصة بأكثر من خمسة آلاف دولار في الليلة الواحدة . .
(2)
تـَعللْ فالهوى عللُ وتذكرْ بأنك بغلُ
وما كل هوى عبثٌ ولا كل الخضروات بقل
هذا هو الاختبار . منشار في الحلق .
(ضع علامة صح أو خطأ على الجمل التالية :
– العرب سلالة هجينة من السلاحف والقطط .
– إن البغال هي التي قامت بتأسيس الحضارات القديمة بحملها السماد والروث والأحجار ورفعها إلى القمم ، وبشق دروب الزراعة وحفر الآبار ، وقد عانت بشدة من جراء المعاملة غير الحميرية ثم نسب المؤرخون إنجازات هذه الحضارات للبشر ، خاصة في إقليم معين اسمه البحرين قديماً ، وهو إقليم شهد أفضل وأجمل أنواع الحمير في العالم فقد كانت بيضاء قوية قاربت الأفراس الأصيلة ، ولكنها بعد ذلك أصبحت رمادية أو صفراء هزيلة نادرة الوجود ثم لم يظهر أي حزب مدافع عن الحمير في ذلك البلد!) ، (يستدعى الشاهد أمين الريحاني وبمعيته كتابه ملوك العرب) .
جثم مضر في القاعة ينتظر النتائج مع حشد من رفاقه البشر ، فجاء حمارٌ ضخم هو المسئول عن لجنة الفحص ، وحدق في ورقة وقرأ اسماً واحداً وقال :
– الأغلبية الساحقة لم تنجح ، بسبب الآراء العتيقة المتسلطة في رؤوسها والتي تمنعها من الرؤية الموضوعية الصادقة ، ولا تزال تعيش في هذيان وخرافات الماضي ، مكذبة كل هذا التطور الصارخ ، ولهذا وببالغ الأسف لا أستطيع سوى أن أسلمكم للجنة المعسكرات تقوم بزرع شيء من العقل في رؤوسكم الفارغة !
ضج الحضور بالاعتراضات لكن المسؤول هدآهم :
– سوف تـُعطوْن في المعسكرات ثلاث وجبات مجانية ، وقهوة وشاي ، وتلتقون بزوجاتكم أو أزواجكن مرة في الأسبوع ، وسوف تشاهدون أفلاماً لكن سوف . . تشتغلون بجدية وليس مثل أعمالكم السابقة في الوزارات والشركات التي خربتموها و . . .
قوطع باحتجاجات وضحكات وتصفير :
– أفضل شيء قلته هو ما يتعلق بالزوجات اللواتي سنلتقي معهن مرة واحدة لحسن الحظ !
– لم تتحدث عن السجائر والشيشة ؟!
– وهل العمل سيكون مكتبياً، أنا لا أعرف الأعمال الخشنة ؟
– سوف يجعلوننا نحرث الحقول يا جماعة !
– ماذا عن الخمارات والمقاهي يا سيد ؟
رد المسئول بهدوء :
– سوف تعملون في الأرض ، ولن تكون هناك خمارات ومقاه والنوم هو عند العاشرة مساءً ، والنساء والرجال سوف يعملون معاً
(3)
تقدمت الكاتبة عائشة الهولية إلى الضابط المسئول في التحقيقات الجارية بشأن تحريضها.
– أولاً أنا لا أعترف بهذا الاستجواب الذي يُعمل من طرف قوة محتلة بمساعدة قوى أجنبية معروفة وعدوة للعرب!
– أين هي القوى المحتلة يا سيدتي؟!
– أنتم جسدها الحيواني الرابض فوق صدرونا!
– ولكن ليس ثمة قوى محتلة، نحن قمنا بهذه الثورة المباركة بعد قرون من إضطهادنا وجعلنا نشتغل في المستنقعات والحقول الخربة حتى كاد نسلنا أن يزول!
– بل هناك القوى الاستعمارية الأمريكية والإسرائيلية وهي التي خططت لكم ودفعتكم لهذا الانقلاب الفاسد العنصري!
– لم يعد يوجد من الأمريكيين سوى القليل، لقد كانوا أول من سافر من الأرض وأستوطن كوكب المريخ ثم أستعمروا كوكب زحل، ولديهم الآن من الثروات والأبنية والرحلات التي سمعت بأخبارها حتى القطط في الكوكب الأرضي التعس!
– لا تهمني هذه الدعاية المغرضة، وأنا أعرف بشكل حدسي وغيبي وواقعي بأن أي شر في المعمورة لا بد أن يكون من الأمريكيين وعملائهم اليهود!
– اليهود كذلك غزوا الكوكب الأصفر وهو كوكب مليء بالذهب والنحاس، وقد أقاموا صيرفة كونية للتعامل بالمواد الثمينة، وأستغرب أن تكون كاتبة لامعة مثلك لا ترعف مثل هذه الأخبار المنتشرة منذ سنوات طويلة!
– كل هذه أكاذيب، لقد كان أبي دقيقاً في أحكامه فلم يعترف بما سمي بغزو القمر، وأنا ابنته وعلى خطاه!
– لماذا لا تتعاونين معنا في نشر التنوير بين العرب؟!
– سنجد في مكتبك الوثير هذا سماعات تنقل كل شيء لأسيادك سواء في الأرض أم في الكواكب!
– يا سيدتي نحن ندير حالنا بأنفسنا، ونحن نريد تعاون كل المثقفين من أجل تطوير حياة العرب.
– لا يمكن التعاون مع قوة إحتلال خاصة إذا كانت من طرف الحمير!
– نحن جزء هام من تاريخكم الحيواني، وقمنا بالثورة مع عناصر نادرة من العرب العقلاء، ونطمع في أن تتفهموا أنتم كذلك أهدافنا الطيبة.
– اليهود وراءكم، اليهود أعداء الله والأمة ولا بد من القضاء عليهم!
– أذهبي وأبحثي عن هؤلاء اليهود وإذا وجدت واحداً فأحضريه إلى هنا!
– وهل تظنني جاهلة، اليهود كائنات خفية، مثل الجراثيم، هم الذين سمموا أفكاركم وكنتم تعيشون بحال جيدة في زرائبنا!
– يا أختي ألا تعقلين قليلاً!
– لا تقل لي أختي، فأنت من عناصر الأحتلال البغيض، ولو كنتُ قنبلة لفجرتُ نفسي فيك!
– ها هي قنبلة وفجري نفسك وفجريني!
– أنت مجرد حمار وإذا إنتهيت لا قيمة لك أما أنا ففلتة في التاريخ!!
ـــــــــــــــــــــــــ
باب البحر «قصص» دار نينوى للدراسات والنشر 2020.
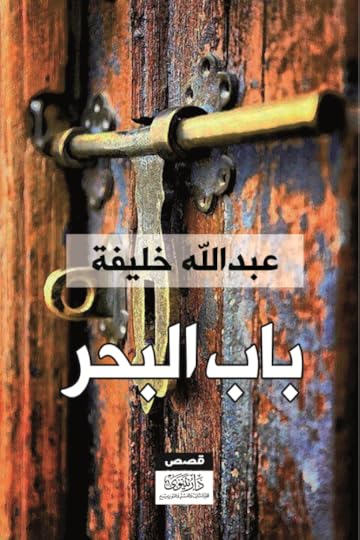
❖ «القصص: وراء البحر.. – كل شيء ليس على ما يرام – قمرٌ فوق دمشق – الحب هو الحب – شجرة في بيت الجيران – المذبحة – إجازة نصف يوم – حادث – البائع والكلب – ماذا تبغين ايتها الكآبة؟ – إمرأة – الربان – إذا أردتَ أن تكونَ حماراً – اللوحة الأخيرة – شاعرُ الصراف الآلي – البيت – حوت – أطروحةٌ – ملكة الشاشة – الغولة – وسواسٌ – مقامة المسرح – إعدام مؤلف – يقظة غريبة».
أنطولــــــــــوجيا الحميــــــــر ـ قصةٌ قصـيرةٌ
ليس هذا دفاعاً أو مرافعةً بقدرِ ما هو بحثٌ تاريخي. تقص دقيق لكائنٍ كان في الأسطورة ذو مقامٍ عال رفيع. في بابل، في مملكةِ القداسةِ الساذجةِ الأولى، إحتلَّ هذا الكائنُ المرهفُ الحسِّ قمةً عالية. لكن قسوةَ خلفاءِ حمورابي، الذين حولوا المدنَ إلى قلاعٍ صماءَ شاهقةٍ عالية ثم إحترقوا فيها وهي صلصال، كتبوا بعضَ خيوطِ هذه المأساة المروعة.
البياضُ الطاهرُ للونِ، البراءةُ، الصفاءُ الروحي الذي يبدو في عينيه، الغفلةُ الكبيرةُ التي تحولتْ لعبودية، كلُ هذه السمات جعلتْ هذا الكائنَ ينحدرُ إلينا، يجيءُ بأعدادٍ وافرة هرباً من قسوةِ الشمالِ وحرائق مدنه.
إنني على أعتابِ رسالةٍ سمها ما شئتَ لكن لا بدَّ لها من حمار. الرسالةُ موجودةٌ لكن الحمارَ غيرَ موجود. هل يمكنُ أن يذهبَ رسولٌ الآن بسيارة مثلاً؟ هذا غيرُ ممكنٍ ومضحك.
حين نبدأُ من حمورابي نجدُ أن الأمرَ بحدِ ذاتهِ كان مشكلةً، هل وصل الحمارُ لدى تلك الحضارة السامقة إلى أن يكون إلهاً حتى أن اسمَ الحاكمِ إلتصقَ بهِ؟ أم أن ذلك راجعٌ لتشابهِ اسم الحاكم مع حمروةِ الأرضِ أو أن الأرضَ حمرّها البشرُ؟ وهم دائماً يلصقون بلادتَهم ووحشيتَهم بهذا الكائنِ العظيم الرقيق.
علينا أن نتذكرَ إن الأجدادَ الأُولَ للحمير كانت هي الحُمُرُ الوحشيةُ المخيفةُ التي تندفعُ كالأعصارِ الملونِ اللحمي الذي يخترقُ الأكواخَ والناس، كانت هناك في الجبالِ بقربِ الأعاصيرِ والبروقِ والنجومِ، بقربِ آلهةِ السماواتِ الحرة، هناك حيث يتخيلُ الإنسانُ كلَ ما هو جميلٌ وحر، من هناك نزلَ أجدادُ هذا الكائن، بل قُلْ تم إصطيادها، عُملتْ لها حفائرُ في الأرض، شباكٌ مشتبكةٌ بأغصانٍ وأحلام، إنشطواتٌ تخطفها إلى أعلى كذبيحةٍ جاهزة.
ثم ظهرَ كائنُنا الجميلُ من المجازرِ للحمرِ الوحشية، من المآدبِ، من السلخِ، من بقايا مسكينةٍ حُبستْ في حظائر، من كائناتٍ فقدتْ أحلامَها وكرامتَها، نشواتُ الرقصِ الصاهلةِ بقربِ رأسِ السماء، الارتفاعُ للذرى، وقطفُ النجومِ؛ سُبختْ كلها على الوحل، إنغرز في لحومِها شوكُ الحظائر، دخلتْ المقابضُ والحدائدُ بين عظامِها ولحمِها، ظهرتْ المسكنةُ عليها، خَضعتْ، ذُلت، سَكنتْ، إرتعبت من كلِ ماهو في الوجود.
هذا الكائنُ الذليلُ الجليلُ إنتشرَ في الفلواتِ والصحارى، تحملَ أعاصيرَ الرمال، نقلَ أكسيرَ الحياةِ، راح اللونُ الأخضرُ ينتشرُ في تلك الساحاتِ الهائلة من الصفار، يحيلُها إلى غاباتٍ من عبّادِ الشمس. يجيءُ الغزاةُ ويخربون الواحات، يقلعون الأشجار، يهلكُ الناسُ، وتهربُ الحميرُ. البشر لا تكاد ترجع خائفةً من الغزاة، يعودُ فلاحٌ، يتسللُ عتال، تأتي الحميرُ بأعدادٍ كبيرة مثل غيم ممطر.
حين تظهر ترتفع الأكواخ، وتتغلغلُ المحاريثُ في التربة، وتتعالى الزغاريدُ والأفراح، وينتشرُ الأطفالُ ضاجين راكبين ظهور الحمير وضاربينها بالعصي، يكادون أن يغرقوها في الجداول وتوصلهم للشواطئ.
حتى بدأتْ تظهرُ المدنُ الجديدة، وصرختْ صفاراتُ الزيتِ تحشدُ الرجالَ من قعرِ الحفر والبساتين، وتضجُّ السياراتُ في دروبِ الحصى المسفلتة قليلاً قليلاً، وتلك الكائناتُ اللطيفةُ تجدُ بعضَ الحرية، بعضَ السرحانِ في الحقولِ الخربة، وفي البراري، حتى أن بعضَها حنَّ ورجعَ للحُمرِ الوحشيةِ فتدفقتْ في جسمهِ الرصاصاتُ، ونُزعتْ الأربطةُ عن رقابِها المتقرحةِ، وخفَ حملها لتنكاتِ المياهِ الثقيلة، ثم أَخذتْ تختفي، الموتُ يخطفها، التزاوجُ منقطعٌ عنها، إلتحاقُها بالجبالِ وبذكرياتِ وماضي الأسلافِ العظامِ ممنوعٌ عليها، وبالكاد يمكنكَ أن تبصرَ حماراً في الشوارع التي إمتلأت بالسياراتِ والأدخنةِ والأدمغةِ الخربةِ والغازاتِ والحمم وسيول العرق والمطر وفيضِ البلاعاتِ، مثلما إختفى النرجسُ وقصصُ الحب العذري، وحدائق البراري، والشطآن البريئة، وحينئذٍ بالضبط جاءتني رسالةُ البصيرةِ: ضرورةُ عودةِ الحميرِ لمدنِنِا وحقولنِا، للتخفيفِ من النعوشِ الكثيرة الذاهبة كل يوم من رياح الصدأ والغبار والحديد والنار.
ذاتَ ليلةٍ بقربِ قلعةٍ أسطورية غرقتْ الأساطيلُ تحتها ، وجثمَ البحرُ عملاقاً قربها، ضربتْ صاعقةٌ أحدَ جدرِانها، وإنشقتْ السماءُ عن خريطةِ ضوءٍ عملاقةٍ، وكلمني النورُ من قمرٍ فضي ذي عيون:
ــ إسمعْ يا عبدالحفيظ عليك أن تحملَ هذه الرسالةَ للناس، لكلِ البشرِ الذين وسعوا ثقبَ الأوزون، إنه إذا لم يَعُد الحميرُ للكرةِ الأرضيةِ فأنتظروا هلاكَكم فيها، لقد حذرتكم من مغبةِ التمادي في قتلِ الغاباتِ والكائنات اللطيفة، أحملْ هذه الرسالةَ وأنشرها.
رحتُ أبحثُ عن الحميرِ مشياً على الأقدام، أرفضُ سيارتي الخاصة، والباص، أستعينُ بدراجةٍ هوائية أحياناً، أطوفُ بأحياءِ المدنِ التي كانت أحياؤها زاخرةً بتلك الكائناتِ فلا أجدُ حتى الديوك، والزرائبُ إنقضتْ وصارت مكعبات حجرية، فسرتُ للقرى، وكنت أسألُ ببراءةٍ فيتطلع لي الناسُ بذهول ما يلبث أن يتشوه ويصير ضحكاً.
قال رجلٌ كهلٌ:
ــ لم يبق في هذه الديرة سوى بعض الحمير الأخيرة، أنا لم أر واحداً منذ مدة طويلة! أتعرف أسطبل حميد الأعرج؟
ــ من أين لي أن أعرف وأنا غريب؟
ــ تعالْ سوف آخذك إليه.
صاحَ فتى:
ــ أقرأْ كتابَ ملوك العرب للريحاني.
سار بي الرجلُ ببطءٍ قاتلٍ وهو يبعثرُ بقايا رئتهِ وما زال يدخنُ سيجارةَ اللف:
ــ ماذا تريد أن تفعل بالحمار؟ لسيركٍ أو لنَذرٍ؟ كانت هنا سلالةٌ من الحمير رائعة لكن أسرة حميد الأعرج قضت عليها بجر الأحمال والأثقال، حتى كادت العائلة أن تفنى لولا ظهور حميد.
في ذلك المرتفع، على تلك التلة، رأيت القرية بقايا وفوضى من أبنية وهشيم، وإندفعتْ من إشداقِها الرياحُ السوداء، وبدت الدكاكين والعمارات والبيوت كفوضى من حصى.
كان الأسطبلُ واسعاً، فيه أحواضٌ واسعة مليئة بالماء، وحظائر جميلة، ومخازن للعلف، وكان ثمة مجموعةٌ من الحمير النظيفة القوية، كان منظرها يشرحُ القلبَ!
لم يخرج لي حميد الأعرج بل خرج رجل سوي، يمشي بشكل عادي، وبدا ودوداً لطيفاً!
رأيت تلك الحمير وجمال المكان ونظافته، فتصورت إن رسالتي قد حُلت!
ــ أشكرك يا أخ حميد على هذه الرعاية الإنسانية للحمير، وأحب أن أقول لك بأنني بحاجة لحمار منها، من أجل قضية هامة، من أجل أن أنشر رسالةً عالمية خطيرة!
ــ خير إن شاء الله؟!
ــ جاءتني رسالةٌ من القمرِ الفضائي الحر وأبلغتني أن أعيدَ الحميرَ لهذا الوجود غير الإنساني، كي تعودَ الصحةُ إليه!
ــ لم أفهم شيئاً وما علاقتي أنا بذلك؟
ــ لديك آخر الحمير في الدنيا، ولا تصلح الرسالة بدون حمار؟!
ــ أتعرف كم كلفني ذلك من التعب والجهد؟ كانت في حالةٍ يُرثى لها، أجسامُها ممزقة، معضوضة، هياكل من العظم، من القذارات، ورحتُ أطببها، وأغذيها، وأشغلها في الحقول المنتجة، وفي الأراضي التي تخصبُ بعد عملها، حتى تراها الآن تتكاثر وتغدو قوية.
ــ هذا هو مضمون رسالتي أيضاً!
ــ لا يا سيد إنني غير مستعد للتخلي عن الجماعة. إذا أردت أن تركب حماراً فلدي واحد، وهو هناك في حجرةٍ ضيقة مسجون فيها، لما يقوم به من مشاكل!
إنتبهت ونظرت ومشيت نحو السجين، وأنا متشوق لرؤيته ومذهول من كلام الأعرج، وما أن إقتربت من الباب حتى رمح الحمار بالداخل وضرب الباب الذي وضعتُ رأسي عليه!
تطلعت من النافذة الصغيرة ورأيتهُ يرمقني بشرر. تراجعتُ للوراء، ووضع الأعرج كفَهُ بلطفٍ يمنع تراجعي السريع!
ــ هذا الحمار المزعج دائم التمرد، حين أخرجه معها يقودها لما وراء الحقول، ويهربُ بها، وهي تتبعه، كأن لديه سحراً خاصاً ، ونلاحقه ، ونتعب كثيراً حتى نُرجع هذه المجموعة التي تكون منهارةً، ومجروحة، وينفقُ بعضها حين ينجرف أو يسقط أو تنفرد به ذئاب!
جلستُ محبطاً، تعبتُ من السير والسؤال. نمتُ. تراءى لي إن الحمارَ من بين القضبان كان ينظر لي ويبتسم، تحدثَ بسخرية:
ــ تدعي إن لديك رسالة! أي رسالة؟! ألا تكفون عن هذه الخزعبلات، منذ التاريخ الأول وأنتم تكتبون، والبلاوي كلها على ظهورنا. وحين كدنا أن نختفي ظهرت أنت لتزعم إنقاذنا؟ إنني أقود هذه البقية الباقية من جنسنا لكي نرتاح من العيش معكم. نحن رسالتنا أن نتخلص من وجودكم ورسائلكم!
ونهق بشكل حاد وضرب البوابة وحطمها وإندفع عليّ جامحاً وكسر حظيرة الحمير وتساقطت الأخشاب بشكل مروع وإنتفضَّ الغبارُ وهاجتْ الكائنات الأليفة الطيفة وإندفعت وراء قائدها منطلقة عبر الدروب المرعوبة نحو التلال، نحو البرية، نحو الحرية وهي تحطم الأسيجة والبراميل!

ــــــــــــــــــــــــــــ
أنطولــــــــــوجيا الحميــــــــر (قصص) دار نينوى للدراسات والنشر ₂₀₁₇ .
❖(القصص: أنطولوجيا الحميـر ــ عمــران ــ علـى أجنحة الـرماد ــ خيمةٌ في الجـوار ــ ناشــرٌ ومنشــورٌ ــ شهوة الأرض ــ إغلاقُ المتحفِ لدواعي الإصلاح ــ طائرٌ في الدخان ــ الحـيُّ والميـــت ــ الأعـزلُ في الشركِ ــ الـرادود ــ تحقيقٌ ــ المطرُ يمـوتُ متسولاً ــ بدون ساقيــــن ــ عودة الشيخ لرباه ــ بيــت الرمـاد ــ صـلاةُ الجــــائع ــ في غابـات الـريف ــ الحيــة ــ العــَلـَم ــ دمـوعُ البقــرة ــ في الثلاجــة ــ مقامات الشيخ معيوف).



