عبـــــــدالله خلــــــــيفة's Blog: https://isaalbuflasablog.wordpress.com , page 42
April 30, 2023
الديمقراطية والتقليدية
كلُ شيءٍ يتغير
April 24, 2023
«الإسلام السياسي» كمصطلح غربي
جاء مصطلحُ (الإسلام السياسي) في العقود الأخيرة من القرن العشرين معبراً عن الرؤى الغربية السياسية في معالجة تاريخ المسلمين المعاصر خاصة.
وهو يعكس عقلية المواجهة للحركات المذهبية المحافظة المتطرفة، لكن أُخذ ذلك بشكل تعميمي، وهو يغدو في الأدبيات العربية الشرقية كتعبير أدبي سياسي موجه ضد الحركات الدينية المعاصرة.
جاءَ التعبيرُ الغربي كجزءٍ من الحملة السياسية ضد حركات مناوئة للعصر، تضع تصفية الآثار التحديثية الحضارية في الشرق، جنباً لجنب مع سياسات الدول الغربية المتدخلة في شؤون وبلدان المسلمين، رغم أن هناك مستويات متعددة من التطور الاجتماعي الإسلامي في هذه العملية، فهناك قوى صحراوية بدوية وريفية عاشت على الألغاء ومن قوى مدنية إستوعبت تقاليد حضارية حديثة ودعت للنمو المتدرج وبضرورة إستيعاب الديمقراطية على مراحل، ولا يمكن إلا قراءة هذه الخطابات ونقد بعضها ودعم الآخر مع تطور العمليات السياسية والاقتصادية التحديثية المشتركة بين الغرب والمسلمين، للوصول لقواسم مشتركة وعمليات تعاون أعمق.
أما ذاك التعبير الغربي وهو تعبير(الإسلام السياسي) فهو قد خضعَ لرؤيةٍ إيديولوجية إستصالية عامة، خاصة عندما إنتقل لقوى ليبرالية ويسارية عربية ليس لها جذور شعبية وديمقراطية.
وقد قامت تطوراتُ العرب والمسلمين الحديثة على مساندة الغرب الإقتصادية والفكرية في الواقع، ومثلت الدراساتُ الغربية في ثقافة وتاريخ الإسلام الشيءَ الكثير، وعكف مئاتُ العلماء الغربيين على فحص مخطوطات إسلامية قديمة وكرسوا أعمارهم لذلك بين الأقطار المتباعدة وبين الكراهية وقلة المساعدات!
وقد فهمتْ الأتجاهاتُ غيرُ الإنسانيةِ في المنطقة ذلكَ كنوعٍ من التآمر والإستغلال، وتوظيفاً للقراءات في عمليات التفرقة بين المسلمين، وربما كان ذلك موجوداً في بعض التحقيقات والرؤى، لكن العملية الثقافية الغربية لدراسةِ الإسلام كانت مفيدة جداً، وتمثل نقلة كبرى تمت الإستفادة منها والتجاوز لها كذلك.
في ذلك الدرس للتاريخ لم يكن ثمة التعميم الراهن (الإسلام السياسي)، وقد كان الدينُ مجموعةً من العمليات الإجتماعية المُسيّسة عموماً، وبالتالي فإن هذا التعميمَ الراهنَ وهو الإسلامُ السياسي المقصودُ به الحركات المحافظة المضادة للعصر، لم يأت من عمليات تحليل الحركات السياسية الاجتماعية الإسلامية الكثيرة كالمعتزلة والقدرية والأشاعرة والقرامطة والمذاهب الإسلامية التي نشأت في أجواء محافظة ولكن عملت على حفظ هياكل الأمم الإسلامية، بل جاء من اللغة الصحفية لهذه الأيام، لأن الكتاب الغربيين المعاصرين إنعزلوا عن نتاج الغرب الهائل نفسه المعالج للإسلام، وجاءوا من الحكومات أو من الصحف أو من شركات النفوذ، فلم يرتكزوا على نتاجات الغرب الديمقراطية في معالجاته للتاريخ ولثقافات الأمم. أي هو إصطلاح نتاج تبسيط، ومؤامرات وصراعات سياسية راهنة لا يجوز أن يُؤخذ لمواقف سياسية عميقة. هو جزءٌ من اللغو لا من التحليل.
الآن حين غدت المعركة سياسية مباشرة بين حركات دينية مضادة للحداثة، وبين حركات تحديثية، علمانية متغربة، جاءَ هذا المصطلحُ المجردُ، رغبةً في عزل هذا الكم الهائل من التعصب والتخلف عن جمهور قراءة الصحف لكن بأدواتٍ غير علمية.
إستعمال هذا المصطلح جاءَ من حركاتٍ ليبراليةٍ ويسارية غيرِ ذاتِ حفرٍ في التاريخ والواقع، وكجزءٍ من الإستيراد الشكلاني، غير النقدي، وتعبيراً عن هشاشة الفئات الوسطى التحديثية غير الصناعية، وتذبذبها بين القوى التقليدية الحكومية والدينية التي لم تؤسس نهضات عربية إسلامية إنسانية متجذرة متطورة.
هو الصراع بين حركات سياسية من الفئات الوسطى نفسها، لكن المتسمة بقلةِ التبصر السياسي، وبمحدوديةِ المعارف، وبالحدية الغربية أو بالحدية الدينية المتصادمتين عبر هذا المصطلح، وهو أمرٌ يكشف ضعف البرامج السياسية لهذه الفئات وتراقصه على الأحداث اليومية بدون تبصر مستقبلي أو معرفة بحال الأمة العربية خاصة وبالأمم الإسلامية عامة، وتبعيات هذه الفئات لقراءات الدول الخارجية غالباً، ولرؤيةِ جهةٍ واحدةٍ من التطور، ولغياب الجدلية التضفيرية بين الأوطان والعصر، بين الأديان والتحديث، بين الشعوب وهذه الفئات الوسطى التي هي نتاجُ البيروقراطيات الحكومية والتجارة الصغيرة الدكاكينة.
والأسوأ إنه يعبر من جهةٍ أخرى عن العامةِ الضحلةِ الوعي، المقسَّمة طائفياً، التي يشكلُ حراكُها ضرراً على نفسها، أكثر من الفوائد التي تجنيها من تسيسها المخرب لعالمها، فهي كل يوم تغوص في الفوضى ويدفعها تعصبها للمزيد من الأزمات.
ويزيد إستخدام مصطلح الإسلام السياسي من هذه الأضرار، لأنه يبعد هذه العامة عن القراءات الموضوعية، ويشحنها بالعدائية للحداثة، ويعمق طائفيتها، بدلاً من تقرأ الإسلام والعصر على ضوء آخر.
إشكاليات التطور السياسي في السودان
كان السودان أثيراً على قلوب العرب وخاصة التقدميين منهم، حيث كان واعداً بتطورات إيجابية كبيرة، كانت ثمة أسماء أسطورية تلتهب في فترة السبعينيات من القرن العشرين، وكان البلد ينزف بين إنتفاضاته الشعبية العظيمة وإنقلاباته الدموية المؤلمة.
حتى أخذتْ عقولنُا تستبصرُ التطورات الماضية بأشكالٍ جديدة، فقاربنا تعقيدات تطور العالم، ولم تعدْ الصيغُ المبسطةُ بقادرةٍ على فهم الواقع المعقد.
وحين نقرأ الآن أدبيات الأحزاب التقدمية والقومية نجد إن الكثيرَ من اللغةِ القديمة لم يتغير، وحتى عمليات التحليل والنقد الذاتية لم تصل إلى أغوارِ التجارب التي نُسفتْ والتي غَامرت والتي تَجمدت.
اقرأ الآن تجربةَ التقدميين السودانيين في السبعينيات فأجد الحيثيات باقية. في سنوات السبعينيات تابعتُ بأسى المجازرَ التي قامَ بها جعفر النميري. كان كتابُ فؤاد مطر، هذا الصحفي الذكي، وهو بأسم (الحزب الشيوعي السوداني نحروه أم إنتحر؟)، وثيقة بالغة الأهمية لكيفيةِ إشتغالِ الصحفي وغوصهِ في تاريخٍ حي، يتدفق بالدماء على أرض الواقع المتأجج بالصراعات، جامعاً بين الحيثيات الحياتية النارية والقراءة الفكرية والوثائق، بين يوميات جعفر النميري في دهسِ المعارضة الدينية في جزيرة آبا وتحويلها إلى مقبرة واسعة، وإنقضاضه على الحكم كأنهُ وليٌّ مقدسٌ نزلَ بدبابةٍ من السماء، وبين براءةِ اليسار وطزاجته وعنفوانه وشموليته الغائرة الخطرة وشموخه وذهابه للمشانق مرفوع الرأس.
حين يحلل الباحثون هذه المجازر وهذه الهبات المندفعة نحو الأعالي بشكلٍ أسطوري، لا يقرأون السببية البسيطة التي كشفها تاريخُ القرن العشرين، وهي أن الثورةَ الاشتراكية في العالم الثالث الراهن هي حلم، وحلم خطر إذا حاول أن يمشي على قدمين في أرض الواقع، ويصبح كابوساً إذا ركب على دبابة. والسؤال المركزي حقيقةً هو هل يستطيع اليسار أن يتجاوز الإقطاع؟!!
سنجد إن جعفر النميري والمناضل الشهيد عبدالخالق محجوب متضادين، لكن ثمة أشياء خطرة جمعت بينهما. لقد كان مشروعُ الإشتراكية يسري في العظامِ السياسية للأمين العام للحزب الشيوعي، صحيح إنه أخذهُ كتتويجٍ لثورةٍ وطنيةٍ ديمقراطية، لكن هنا هي المشكلة.
في تقييمه لإنقلاب مايو 1969 الذي قام به جعفر النميري، والذي إندفع بقوة وسرعة لكي يكون نظاماً شمولياً متغلغلاً في كلِ شيء، وجامعاً كل السلطات العسكرية والأمنية والسياسية والثقافية بين يديه، تحدث الأمين العام للحزب عبدالخالق محجوب عن قوتين بارزتين أخذتا تهيمنان على مسرحِ السودان السياسي، وهما قوة البرجوازية الصغيرة الممثلة بالضباط الذين تولوا السلطة، وبقوة الطبقة العاملة التي تمثل طليعة الثورة الحقيقية وطليعة العاملين حسب تصوره.
جاءَ في بيان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي صبيحة يوم الإنقلاب 25 مايو1969 ما يلي:
(ماجري صباح هذا اليوم انقلاب عسكري وليس عملاً شعبياً مسلحاً قامت به قوى الجبهة الوطنية الديمقراطية عن طريق قسمها المسلح، وأصبحت السلطة تتشكلُ من فئة البورجوازية الصغيرة.
يبني الحزبُ موقفَهُ من هذه السلطة على أساس: دعمها وحمايتها امام خطر الثورة المضادة، وأن يحتفظ الحزب بقدراته الايجابية في نقد وكشف مناهج البورجوازية الصغيرة وتطلعاتها غير المؤسسة لنقل قيادة الثورة من يد الطبقة العاملة الى يدها، فالبورجوازية الصغيرة ليس في استطاعتها السير بحركة الثورة الديمقراطية بطريقة متصلة.).
إن هذا التقييمَ يحشرُ العمليةَ السياسية في ممر إجتماعي ضيق خاطئ، فالصراع ليس بين طبقتين، بل هو في طبقة واحدة هي البرجوازية الصغيرة نفسها، فهؤلاء العسكريون والسياسيون المتحدون على التغيير هم شرائح من هذه الطبقة، والحزب الشيوعي هنا إحدى هذه الشرائح، لكنه يتوهم إيديولوجياً بأنه ممثل الطبقة العاملة، وبالتالي هو يستطيع دون سواه أن يحدد الطريق الاشتراكي، لأنه ممثل العمال. وهل العمال يريدون الاشتراكية أو يفهمونها؟ وأية شروط موضوعية من تصنيع واسع وغيره من الظروف يؤهل السودان الإقطاعي الزراعي – الديني، الممزق لمثل هذه الأحلام التي تنسجها النخب؟
هذه النخبُ نسجتْ هذه التصورات الإيديولوجية بعد عجزِ ممثلي القوى الاجتماعية التقليدية عن فتح طريق النهضة الصناعية والديمقراطية للشعب، نظراً لارتكاز القوى التقيدية كحزب الأمة على الملكية الزراعية الإقطاعية وعلى الطوائف والقبائل والشركات والبنوك المالية الطافحة فوق جسدٍ إقتصادي إقطاعي متخلف، ممزق، مركزي!
وحين يتقدم الحزب الشيوعي بين هذا الكم الشعبي البسيط العائش في إقتصاد ما قبل رأسمالي بشكل واسع، ليقوده إلى الإشتراكية يؤكد عدم نضجه السياسي.
صحيح إنه قال إنه يعمل لتنمية العناصر النضالية الديمقراطية تتويجاً للانتقال إلى الإشتراكية لكنه قال كذلك بأن ثمة (مأزق للتطور الرأسمالي في السودان)، وإنه قادر على إزاحة ممثلي البرجوازية الصغيرة بعد حمايتها وتصويب خطواتها، مما يعبر عن وصايته على الثورة الشعبية، واحتمالات تطورها، وهو أمر يجعل الدكتاتور العسكري الأرعن يزداد رعونة!
إن الخطاب السياسي للحزب بالتوجه إلى الإشتراكية هو الخطابُ المسبب لأزمة المرحلة، وبطبيعة الحال هناك الدعم السوفيتي لمثل هذه المغامرات، وهو أمرٌ يجعلُ القوى التقليدية تضطربُ وتتحركُ في مغامرات لوقف هذا التعدي على (الملكية الخاصة) وعلى (الدين)، وهي إثارات لتحريض الدول الأخرى خاصة مصر التي بدأتْ تنتقلُ لحكم السادات في ظلِ ذلك البرزخ التحولي الهدام من عبدالناصر للسادات، ولذا كانت أحداث جزيرة آبا وتطبيقات النميري للاشتراكية العسكرية وإستغلاله لشعارات الحزب الشيوعي لضربه وسحب البساط من تحت أقدامه مدعاةً لمراجعة هذا الخط وتغييره.
إن كل هذه الإستراتيجية تقودُ إلى فك العلاقات مع الحلفاء وعدم تصعيد عناصر الديمقراطية والنهضوية الصغيرة والدخول في سيناريوهات القفزات والمذابح!
لقد كان السودان قريباً من مغامرة (الإشتراكية) التي صعَّدها الحزبُ الشيوعي السوداني بحسنِ نية، وإستغلها جعفر النميري بسوءِ نية.
وقد كان كان المسرحُ الستيني العربي مهيئاً لمجموعةٍ من هذه المغامراتِ الخطرة، التي ألحقتْ أضراراً فادحةً بعملياتِ التطور الاجتماعي الديمقراطية.
كان هناك صراعٌ فكري في الحزب الشيوعي السوداني نفسه، فقد ظهرَ فيه صراعُ البلاشفة والمناشفة! صراعُ المناضلين المعتمدين على سواعد الجماهير العاملة وعبر نضالها حتى تغدو السلطة تتويجاً لهذا الكفاح، وهذا هو التوجه البلشفي. في حين يمضي التوجه المنشفي للاستعانة بالانقلابيين العسكريين وبالقوى العليا من أجل الإسراع بالتحولات!
يتصور التقدميون السودانيون أنفسهم هنا إنهم في دولةٍ شبهِ صناعيةٍ شبهِ متطورةٍ، ويصعدون على المسرح التاريخي وكلٌ منهم لبسَ عباءاتٍ تاريخيةً مهيبة، لكي يقفزَ إلى دورهِ العظيم ويحققَ الإشتراكية! وقد نسوا المهمات الحقيقية البسيطة والعظيمة والصعبة جداً كذلك في مثل هذا الواقع الشديد التخلف.
يتصور عبدالخالق محجوب بأنه لينين آخر، وإنه سوف يهزمُ المنحرفين والانتهازيين داخلَ الحزب، ليجمع مختلف القوى ويحقق الثورة المنتظرة الديمقراطية أولاً ثم الاشتراكية ثانياً على السياق السوفيتي.
لكن الدكتاتور النميري تشبع بأدبيات المرحلة بشكلٍ أكثرَ سرعةً وخفة وفجاجة وفساداً، فقد خطفَ (الثورة) المزعومةَ من خصمهِ اللدود، ثم راح يقفز بها من كارثة إلى أخرى، ففي الذكرى السنوية الأولى لانقلابهِ قام بالتأميمات لكافةِ الشركات الكبرى والعديد من المتاجر والدكاكين. وبهذا فقد حقق الإشتراكية كما يتوهم وقد أعطته هذه التأميمات مزيداً من القوة والتمدد وكسب الانتهازيين.
وهذه مثل ثنائيات أخرى كثنائية الحزب الشيوعي العراقي والبعث. أو بن بيلا وبومدين، أو ثنائية عبدالناصر واليسار المصري الخ.
ولم يعارضْ الحزبُ الشيوعي فكرةَ الإشتراكية أصلاً، بل عارضَ سوءَ تطبيقاتِها ولعدمِ قيامِها على أسسٍ قانونية معتدلة، ولحدوثِ الفساد الكبير فيها، وكأنه لو طبقها الحزب نفسه لاستطاع أن ينجو بها، ويأخذها إلى التطبيق الصحيح.
دون أن يقرأ بأن فكرةَ الاشتراكية نفسها غيرُ ممكنة في مجتمعات شرقية متخلفة ، وإستبدادية، ودينية غير عقلانية، وغير رأسمالية متطورة!
وهو أمرٌ يعودُ للقراءة الماركسية – اللينينية الدينية المقدسة.
فلحظةُ عبدالخالق محجوب هي لحظةٌ إستعاديةٌ لينينية، وهي قابُ قوسين أو أدنى من الثورة العمالية الموعودة، أي أنه على العكس كان ينبغي قلب مثل هذه اللحظة، وضرورة نقد هذه الفكرة وإستمرارا النضال الديمقراطية من أجل سودان رأسمالي ديمقراطي موحد متطور، فخلق مثل هذه التراكمات الديمقراطية هو الذي سوف يطور الحلفاء ويوجه التغيير نحو الظروف الإقطاعية السائدة، ويوجه العمل لتغيير الثقافة الدينية والسحرية، ونشر التعليم والتصنيع، ومحو الأمية، وتغيير حياة الأغلبية الفقيرة.
لقد رأينا إنه في الوقت الذي وجدنا جماهير الإقطاع الديني تحتشد للدفاع عن زعمائها وتلبية لنداءاتها في تلك الجزيرة المجزرة، أو في ما تلاها من أنشطة سياسية ختامها كان ثورة الإنقاذ الكارثية، في حين إنه حين ذبح الزعماء التقدميين، أو قيام فصيل منهم بإنقلاب ضد النميري عبر إنقلاب هاشم العطا وإفشاله لم نلحظ حراكاً وأسعاً للجماهير العمالية طليعة الثورة الاشتراكية؟!
كانت التحركات الكثيفة للجمهور الديني الذي لم يشتغل عليه التقدميون وتركوه غنيمة وفريسة للإقطاع، هي الكثيفة، وهي التي أكدت نفسها وصعّدت جماعاتها لتستغلَ فراغَ غياب التقدميين الحاد والمأساوي، وكذلك رأينا صعود القطعات العسكرية، والطائرات المصرية والليبيية التي ضربتْ الانقلابَ وأعادت النميري في حلةٍ جديدةٍ من الوحشية، وبهذا فقد قدمت القيادةُ الحزبيةُ الشيوعيةُ طلائعَها التي تعبتْ في تشكيلها عبر عقود وجبةً سهلةً للقطعات الحربية الأجنبية المتدخلة المغيرة ولجماعات النميري التي حُررت من الأسر السهل.
فيما تُركت الأرض السودانية الاجتماعية للقوى المذهبية والإقطاعية والعسكرية، دون أن يكون ثمة تنظيم تنويري ديمقراطي يوجه الناس نحو حل المشكلات المحورية مثل الطائفية والأمية وأشد حالات الفقر والفساد وتنمية الوحدة الوطنية والليبرالية والديمقراطية.
إن الهزائم والانكسارات السياسية الحادة لها نتائج وخيمة فيما بعد وهي تتطلبُ جهوداً وتضحياتٍ أكبرَ لتجاوزِها، وخاصةً على مستوى تطوير الرؤى، فتجاوز النسخة الماركسية الاستيرادية يتطلبُ قراءاتٍ عميقةً للواقع، ودراسةَ الإسلام والمسيحية وخلقَ مستويات إجتماعية عقلانية ديمقراطية فيهما مع إستمرار المادية الجدلية في نشاطها الإنتاجي البحثي السياسي، وبضرورة تطوير القوى المنتجة الخاصة والعامة، فلم تعدْ الدولةُ السودانية مثلما كانت في فضاءٍ عسكري محض، بل غدت دولةً شمولية ذات ملكية إنتاجية وقوة إقتصادية وإجتماعية هامة مثل العديد من الدول الشرقية التي تجاوزت فضاء الستينيات (الحر) بُعيد الاستقلال، ويحتاج تجاوز شموليتها إلى صعود كبير للرأسمالية الخاصة المنتجة، ووحدة المنتجين.
#السودان #عبدالخالق_محجوب #الحزب_الشيوعي_السوداني Sudan#
April 23, 2023
حوار مع العفيف الأخضر
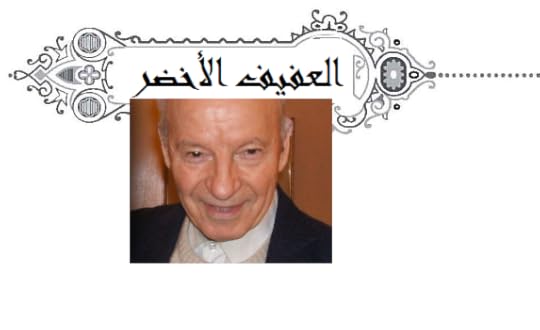
الباحث العفيف الأخضر من العقول النقدية المهمة التي نشطتْ الوعي العربي في عمليات كشف الواقع المتعدد البُنى والأنظمة والتراكيب.
وهو له دائماً قراءاتهُ التحليليةُ العميقة وتبدو الآن متباعدةً ونادرةً ولكنها ثمينة، وكان في دراساتٍ سابقةٍ يغوصُ في تعقيداتِ الهياكل الاجتماعية في عموم الشرق كما فعل في دراسة له في مجلة (قضايا فكرية) قبل سنوات، وقد كنتُ قد تابعتُ أولَ ظهورٍ فكري له في كتابِ (العسف)، عن التعذيب في الجزائر، الذي ظهرَ بعد انقلاب بومدين، فرفقتي معه طويلة!
في آخر مقالة له نشرت في موقع (الحوار المتمدن) وهي بعنوان (لماذا إصلاح الإسلام؟)، نقرأ له طرحاً يدعو لإصلاحِ الإسلام ككل عبر رؤيةٍ عامةٍ مجردة لكنها فيها تفاصيل غنية، ونقتطفُ فقرةً من مقالته رغم طولها لكنها مهمة لعرضِ وجهةِ نظرهِ:
(أمام الإسلام اليوم، أعني صناع القرار المسلمين، خياران: المراوحة في المكان أو الإصلاح. المراوحة في المكان أعطت على مرّ السنين حرباً دائمة مع الذات وحرباً مع العالم وحرباً مع العلم وحرباً مع الحداثة. إصلاح الإسلام يطمح إلى مصالحة الإسلام مع نفسه، ومع العالم الذي يعيش فيه، ومع العلم الذي يحقق اكتشافاً مهماً كل دقيقة بعضها يطرح على الوعي الإسلامي التقليدي أسئلة مُحرجة. ومع الحداثة بما هي مؤسسات سياسية وعلوم وقيم إنسانية كونية أي يسلم بسدادها ذوو العقول السليمة أينما كانوا.
مصالحة الإسلام مع نفسه بوضع حدّ للتكفير سواء تكفير المثقفين أو الفرق الإسلامية الأخرى كالمتصوفة والدروز والعلويين والأحمديين والبهائيين والشيعة…. وبوضع حد للحرب السنية – الشيعية الدائمة التي توشك أن تتحول اليوم إلى سباق تسلح نووي بين إيران وجوارها السني حامل لأخطار الحرب النووية وذلك بقبول الفصل بين الديني والسياسي، مصالحة الإسلام مع العالم تتطلب منه إعادة تعريف عميقة لعلاقته به تُنهي تقسيمه إلى دار إسلام موعودة بالتوسع ودار حرب موعودة بـ”الجهاد إلى قيام الساعة” كما يقول حديث للبخاري يَتَلَقنه المراهقون في دروس التربية الإسلامية في عدة بلدان، مصالحة الإسلام مع العلم تقتضي نسيان الإعجاز العلمي في القرآن وقبول الفصل النهائي بين القرآن والبحث العلمي والإبداع الأدبي والفني).
هذه أفكارٌ مهمةٌ لكنها مطروحة في عرض عام مجرد، رغم تخصصيها الخطاب بالتوجه نحو (صناع القرار)، فصناعُ القرارِ عموماً هم جزءٌ كبيرٌ من المشكلة. وتعبيراتٌ مثل تصالح الإسلام مع نفسه تنقلنا إلى مثاليةٍ غيرِ ماديةٍ تماماً.
التجريدُ والتعميمُ في كلامِ العفيف الأخضر يتركزان في رؤيتهِ تاريخ المسلمين المعاصرين كتاريخٍ عام، ليس فيه بُنى اجتماعيةٍ ذاتِ قوانين، وان تغييرَ حالِ المسلمين يتطلبُ رؤية هذه البُنى، ورؤية كيف تتناقض وتنمو أو تتحطم، وبهذا لابد أن نعرف لماذا كان خطابُ الإمام محمد عبده بهذا الشكل دون ذاك؟ لماذا استطاع محمد عبده أن يكون مجتهداً ولم يستطع الأزهرُ ذلك؟ (لقد خصص العفيفُ عبارةً من مقالته عن محمد عبده).
هذا يتطلبُ رؤيةَ تاريخهِ وتاريخَ البنية الاجتماعية التي جاهد فيها، وكيف كان مثقفاً دينياً مستقلاً بسبب خطاب الأفغاني الذي تبناه وكان خطاباً إسلامياً عاماً مستقلاً، وحيث كان الزعيمان منسلخين من وجهة نظر الأنظمة الشرقية الشديدة المحافظة في ذلك الوقت، ومقاربين للحداثةِ الغربيةِ في بعضِ توجهاتها الديمقراطية التنويرية، لكن هذه الوجهات النظر الإصلاحية ظلت فرديةً وفي سياقٍ ديني تقليدي كذلك.
أما الأزهر فكان تابعاً للقوى التقليدية خاصة المَلكية المصرية المحافظة وقتذاك، وقد ابتعدت القوى الدينيةُ المصريةُ عن أفكارِ المُجاهَدين الشيخين، في حين إن هذه الأفكارَ انتقلتْ وتم تبنيها لدى الوفد، وفي سياقٍ فكري مختلف كذلك، فكرست القوى التقليدية المتعددةُ من القصر الملكي والاخوان المسلمين والسيطرة البريطانية، رغم التباين بينها كذلك، نفسَها ضد الوفد وتطوره، أي ضد انتصار خيار الرأسمالية الخاصة المستقلة الديمقراطية.
هذه عينةٌ صغيرةٌ من التاريخ أقتطفُها لقراءةِ السببيات العامة وتعقيد وتركيب أي مرحلة، حيث واجهتْ القوى التقليدية نموَ الرأسمالية الخاصة المجسدة بالوفد، ثم ظهرتْ الرأسماليةُ الحكوميةُ العسكرية المجسدة بثورةِ يوليو لكي تقومَ بإصلاحٍ اقتصادي كبير، لكن الرأسمالية الحكومية ذات الشكل الدكتاتوري تنتهي بكوارث عادة. وتغدو المشكلاتُ الأكثر تعقيداً في مسائل الديمقراطية وقراءة التراث وتغيير الريف وقضايا الفساد ضرائبَ كبيرةً يجب أن تدفعها القوى الاجتماعية في مرحلةٍ تالية.
من هم صناعُ القرارِ في مصر حالياً ؟! وهل يمكن أن يتفقوا على حلولٍ مشتركة؟
إن صناعَ القرار بشكل كبير هم المسيطرون على الرأسمالية الحكومية كما جاءتهم من الفتراتِ السابقة وكما هيمنوا عليها وأضافوا تغييرات و(خصخصة) زادت الاقتصادَ فساداً وضياعاً، وهم يرفضون الانزياحَ عنها وعن فيوضِها المالية خاصةً!
وهناك الاخوان المسلمون كقوى رأسمالية – محافظة ذات جذور زراعية، ومنذ البداية رفضوا الإرث التنويري الديمقراطي من المجاهَدين الكبيرين السالفي الذكر، ومن الوفد كقوةٍ وطنية، ولكنهم في صراعاتهم الراهنة، وغياب الدكتاتورية العسكرية التي شوهت تاريخهم، أخذوا يبحثون عن أشياء جديدة ويجتهدون، لكن دون المقاربة مع الحداثة الغربية الديمقراطية التي يذوبونها بآليةٍ في الاستعمار دون تفريق عميق ودون قراءات مركبة بين الحداثة والاستعمار.
إن تغييبَ الإنجازات الديمقراطية لدى الوفد والرواد يتحدُ مع تغييبِ الإنجازات الديمقراطية لدى الغرب ولدى الثورة الإسلامية التأسيسية كذلك!
إن الترابط مع الاستبداديات الأبوية خاصة داخل الأسرة، وفي الثقافة، وغيابهم عن رأس المال الصناعي، وهيمنتهم على عامةٍ أمية غيرِ قادرةٍ على التطور السياسي، تجعل قدراتهم كمشاركين في المسئوليةِ النهضوية الراهنة تتجهُ لعدمِ تطوير الأحكام الشرعية والأفكار السياسية باتجاه العقلانية والمساواة والأنسنة.
تعتمد أفكار الأستاذ العفيف الأخضر في مقالته الآنفة الذكر (لماذا إصلاح الإسلام؟)، على التجريد العام وعلى أفكار تنويرية مهمة كذلك، لكنها تنمو داخل ذلك التجريد.
لقد وصلنا إلى تحديد بعض القوى السياسية الفاعلة الأساسية في بُنيةٍ عربيةٍ مركزيةٍ هي البنيةُ المصرية النموذجية لعمليةِ استنتاجٍ تظلُ محصورةً بها، ولا يمكن كذلك تعميمها، من أجل رؤية السببيات الكبرى هنا. وقد رأينا أصحابَ القرار الذين دعاهم العفيف الأخضر لكي يقوموا بتجديد الإسلام وتحديثه.
ورأينا كيف أن الرأسمالية الحكومية المصرية والرأسمالية الدينية المحافظة الممثلة بالاخوان المسلمين، غير قادرتين على تجديد الإسلام، لأن الأولى تتشبثُ بالمقاعدِ السلطويةِ وبإدارةِ المال العام للمواطنين، بلا أمانة، والثانية الرأسمالية المحافظة الدينية التي جاءتْ من أموالٍ أخرى نفطية وبنكية، تظلُ تريد محدوديةً في الوعي الديني لدى المودعين الصغار والعامة التابعة الغارقة في إسلام العبادات، من دون تبصر لما هو أبعد من ذلك، أي لمهمات التغيير في البُنى الاجتماعية المختلفة.
في حين أن القوةَ الثالثةَ وهي الرأسمالية الخاصة فهي أقسامٌ مشتتة، متصارعة، لديها أفكارٌ ليبراليةٌ وتجديدية، ولكنها محدودة الشعبية بسبب عدم اشتغالها فيما يشكلُ الأرزاقَ الواسعةَ لدى الجمهور، أي في الرأسمالِ الصناعي، وبالتالي هي تعجزُ عن إنتاجِ الرأسمال الفكري التجديدي.
أما اليسار فهو أقل قدرة سياسية من إحداث التجديد في الإسلام من الناحية السياسية العامة، لاعتمادهِ على عامةٍ محدودة الوعي ولا تشتغلُ بالتجديد الفكري، على الرغم من مقاربة مثقفي اليسار لتجديد الحياة أكثر من غيرهم وأعمق من بقية القوى. ودور اليسار مهم في تجميع القوى السياسية لمعركة العلمانية وتجديد حال المسلمين ومن أجل الحداثة والديمقراطية، بشرط أن يكون هذا اليسار نظيفاً غير مرتبط بقوى استغلال وفساد!
لكي يحدثَ تجديدٌ للإسلام، أي من أجل إبعاد هذه العادات ومستويات الأفكار التي كرستها القوى المحافظةُ خلال القرون السابقة والزمن الحاضر، لابد من التفاعل الديمقراطي بين القوى السياسية السابقة الذكر، وأن يتم إبعاد هذا المستوى المحافظ وهو الذي شكلتهُ في الواقع قوى استغلال المسلمين، عن الحكم، أي ألا تتكرس تلك القوى كقوى دينية، مهيمنة على النصوص، وأن تتجسد كقوى سياسية مجردة من تلك الملكية المقدسة للنصوص.
القوى الرئيسية لا تريد الابتعاد عن مطلق السلطة ومطلق التحدث باسم الدين. ولا بد كمعركة سياسية أساسية أولى من إحداث هذه النقلة التاريخية! الكراسي الدافقة للمال بين الطبقة الرأسمالية البيروقراطية – الدينية، سواء أكانت كراسي عالية أم كراسي برلمانية أم نقابية فاسدة، هي العقبة أمام تجديد الإسلام وتجديد الأوطان من هذا الجمود!
إن العديد من رجال الدين والتجار ومن المثقفين لو حصلوا على فرص للعيش وافتتاح مصانع أو ورش أو جرائد وغيرها من وسائل العمل، لجددوا رؤاهم واجتهدوا لتطوير الأحكام والأفكار ولكن كيف وهيمنة الدول على الأسواق والمال العام عقبة كبرى دون ذلك؟
من هنا تغدو نضالية اليسار الديمقراطي غير المرتبط بالفساد الحكومي والأهلى على السواء، هي القوة الفاعلة لتحليل أي بناء عربي اجتماعي، فلكل بلد عربي خصائصه ودرجة تطوره وتباين أهدافه السياسية القريبة، ومقاربة مختلف القوى بدرجات اقترابها مع مشروع الحداثة السابق الذكر، ومن دون هذا اليسار الفاعل، النشط، المحلل، فإن كل القوى تدخل في عمليات تجريب وفوضى وتراجع، لا تستطيع أن تستكشف الآفاق السياسية المراد السير فيها.
هذا هو الخيار أما أن يجلس أصحاب القرار لكي يتداوالوا أمر تغيير المجتمع، وإصلاح الدين، فأين يمكن أن يجتمعوا وفي أي فضاء مجرد يحدث هذا الاجتماع؟!
إن بلداً عربياً أو إسلامياً له درجة مقاربة مع الحداثة أكبر من بلد آخر، فتونس أقرب للحداثة من السعودية، ومن غير الممكن توحد المهمات في البلدين، لكن هذا لا يمنع أن كل دولة فيهما تبقى هي القوة المسيطرة كثيراً وكبيراً وأن مشروع الحداثة الديمقراطي النوعي غير موجود في البلدين. وبطبيعة الحال كانت قيادة تونس قد اختارت دولة الرأسمالية الخاصة وأنتج هذا الاختيار تحولات اجتماعية ديمقراطية أكبر بكثير من السعودية، والسعودية اختارت الرأسمالية الحكومية المسنودة بعلاقات بدوية وأبوية محافظة، لكن الرأسمالية الخاصة والقوى الليبرالية موجودةٌ وتنمو وتطالبُ بحريات. مثلما أن تونس لاتزال الدولة مهيمنة ورأسماليتها الحكومية هي المسيطرة.
هذا العرضُ العامُ ينفي الجزئيات المقطوعة عن السياقات، أو أنه يضعُها في أمكنتِها المناسبة، فنحن نثمن حريات تونس الفكرية لكن لا نجعلها مطلقة، وأن البلدين القيمين في تجربتيهما تونس والمغرب، لا يعني إنهما مكتملان في مسألة الحريات الجوهرية، فلاتزال أجهزةُ الدول العميقة تملكُ الكثير وتوجهُ الحياةَ كما تريد.
ثم نأتي لمسائل جوهرية أخرى تفضل الأستاذ العفيف الأخضر بطرحِها في مقالته السالفة الذكر “لماذا إصلاح الإسلام؟”، وأهمها أن يقوم الإسلام بحلِ خلافاتهِ وإنهائها عن طريق اجتماع العقلاء من الطوائف لإزالة هذا الصراع الخطر بين السنة والشيعة الذي يكاد أن يتفجر في الخليج والجزيرة العربية.
هي دعوةٌ مطلوبة ومشكورة، وحبذا لو حدثت مثل هذه اللقاءات، وتكرستْ بلقاءاتِ المثقفين والساسة. ولكن تظل هذه دعوة تجريدية كذلك، فكلُ بلدٍ يواجهُ مهماتِ تحولٍ وصراعاتٍ ملموسة ساخنة مميزة ومختلفة، ومن أهم واجبات اليسار الديمقراطي في هذه البلدان فحص هذه الصراعات وتحليلها وتجميع القوى السياسية حول حلولها بغرض إحداث تحولات باتجاه الديمقراطية والسلام والتطور.
فتأجيجُ الصراعاتِ الطائفية السياسية مؤخراً تم بسبب تصاعد دور العسكر الإيراني وتشديد قبضته على السلطة، مما جعلهُ يؤجج المنطقة ويدخلها في حروب، وهو أمرٌ ليس مضرا بطائفة من الطوائف فقط بل هو عملية إضرار بشعوب المنطقة ككل والبشرية كذلك، وهو أمرٌ لا علاقة بالشيعة والسنة، فهو صراع سياسي على السلطة، ولكن هذا الصراع السياسي يتموه بالصراع الطائفي منعاً لكشفه واستمراراً لوجوده.
وفي هذه اللحظة المفصلية ونحن نزحفُ نحو بركان مفتوح بفعلِ مغامراتِ جماعةٍ غير مسئولة، تغدو عملية مساندة القوى الشعبية الإيرانية المطالبة بالديمقراطية والتنمية والسلام في بلدها، من أكثر المهمات أهمية.
إن مقاربات الشيعة والسنة وبقية المذاهب الإسلامية والأفكار الديمقراطية التحديثية، لا تحدثُ في المجرد، ولا عبر اجتماع حكماء معزولين عن قضايا الصراعِ الملتهبة، بل تحدثُ في مثلِ هذه القضايا، تحدثُ من خلال نضالِهم المشترك من أجل الحياة والسلام، من أجل وقف مغامرات العسكريين، ووقف التدخلات الأجنبية في شئون الدول الإسلامية، ورفع أيدي الدول الشمولية في المنطقة عن الموارد والاقتصاد، وبضرورة توزيع الخيرات المادية على المواطنين ككل، مثل توزيعها على أهل صنعاء وصعدة والجنوب بشكل متساو، وبعدم تحكم فصيل في قضايا الحرب والسلم والثروة، وفي ضرورة النضال من أجل إنتاج الدولة الديمقراطية العلمانية ذات الجذور الإسلامية والمسيحية وغير هذا من المهمات المحورية في حياة المسلمين، التي هي قضايا الوجود السياسي الكبير، قضايا الحياة الفاعلة أو التفكك والفوضى.
أما قضايا الحياة الاجتماعية المعبرة عن تخلف حياة المسلمين قرونا طويلة كقضايا العقوبات غير العادلة وتعدد الزوجات وقضية الجهاد وتطبيق الحدود وغيرها من القضايا، فإنها ارتبطت ببنى اجتماعية مختلفة، كانت ثمار ظروفها الخاصة، ونحن نجد انه حتى الحكومات التقليدية تراجع مثل هذه الحدود والقوانين بشكل متدرج، في حين أن الحكومات العسكرية الدكتاتورية تواصل التشدد في قضايا الحدود بغرض السيطرة على الناس وليس الحفاظ على الشريعة.
ويعتبر الجهاد مسألة مهمة في مقاومة الغزاة ولا يمكن شطبه، وهو مختلف عن الغزو وعن الإرهاب، وقد أسس الجهادُ أمم المسلمين المتعددة، ولكنه ليس الغزو ونهب الشعوب.
إن إصلاح الحياة الاجتماعية للمسلمين مسألة متدرجة طويلة تعتمد على نمو فقه ديمقراطي، متنوع، مجتهد يتابع الظروف والحالات الملموسة للبشر ولا يصدر أحكاماً عامة تجريدية متعسفة، مثل وعي القضاة الدارسين لكل حالة، في ضوء المصلحة العامة، والمعيار هو دور الأحكام في تقدم المسلمين.
إن كل قضايانا السياسية والاجتماعية تعتمد على حل قضايانا النظامية التشكيلية، أي انتقالنا من أنظمة شبه إقطاعية – شبه رأسمالية، تهيمنُ عليها كلها أنظمةٌ رأسماليةٌ حكومية بيروقراطية فاسدة، لا تريد الانتقال للرأسمالية الحرة، بطريقة الغرب الحداثية، وأغلبية المعارضات تعيشُ في الأفق الاجتماعي نفسه، ومن دون وجود قوى يسار ديمقراطية ترفض مثل هذا الخيار، وتجمع قوى واسعة للانتقال الحقيقي للديمقراطية، ستظل التغييرات جزئية ترقيعية.
إن التراكمات النضالية السياسية العامة، والنضالات داخل البنى الاجتماعية، تتواصل في الواقع، وسوف تزداد عبر السنوات القادمة، وسوف تحدث تحولات على صعيد الحكم وعلى صعيد مفارقة الأحكام الفقهية المحافظة كذلك، أمم الغرب احتاجت إلى عشرة قرون لتحولها الواسع، ونحن لا نريد أن نصبر بضعة عقود.
إن الحوار مع باحث مثل العفيف الأخضر هو حوار خصب يفجر شرارات المعرفة ويجعل المحاور يتعلم من مناضل كرس عمره من أجل تطور أمته والعالم.
أهمية الديالكتيك!
لم تستطع الحضارة العربية الاسلامية أن تجذر كلمة مثل (الديالكتيك)، وهي التي تعني رؤية التناقضات في الأشياء باعتبار هذه التناقضات هي المحركة للظواهر السياسية والاجتماعية.
فهناك دائماً نظرة إلى جهة وحيدة، وإلى زاوية صغيرة بدلاً من رؤية التضادات والجوانب المتصارعة والجوانب السلبية في الأشياء الإيجابية، والجوانب الايجابية في الأشياء السلبية.
فحتى في الاستعمار هناك جوانب إيجابية، فالاستعمار يقوم على ضرورة، وعلى مستويات من التطور الموضوعي المختلفة بين الشعوب، فهو يشكل قواعد اقتصادية وثقافية مختلفة عن الماضي، وفي حالة الشعوب المتخلفة الضعيفة تحتاج إلى سنوات كي تستوعب هذه القواعد وتتجاوزها، تهضمها من أجل أن تنفي الاستعمار، أن تستوعب منجزاته الحضارية: السكك الحديد، والعلوم والحرية، الخ.. لكي تكون أفضل منه.
أما الفكر الشمولى المنغلق غير الديالكتيكي فيوجه الناس إلى الجانب المضاد إلى كراهية الاستعمار والعودة للتخلف، أي الانحصار في الحياة لما قبل الحداثة، وعدم رؤية التنوع والانحباس في النظرة غير الموضوعية، والعودة لتراث غير علمي، لا يرى خصوبة التناقضات والقراءة الموضوعية للواقع، ويجعل العرب معلقين في فراغ خيالي وعاطفي.
كل شيء سيئ فيه جانب إيجابي، والظواهر الدينية المنغلقة فيها جانب إيجابي كذلك، وهو العودة للجذور وقراءة الماضي وهو سبب التخلف وسبب التقدم أيضاً.
لقد حاول العرب تغيير أنفسهم بالاستيراد دون أن يغيروا البدلات القديمة التي لبسوها طوال قرون. وعودتهم المرضية إلى التراث هي بسبب سيادة النظرات الوحيدة الجانب، بسبب عدم القدرة على الجمع بين الحداثة والجذور، ولهذا يندفعون إلى جهة وحيدة، إلى زقاق مسدود، ثم يندفعون إلى زقاق مسدود آخر، وتدخل في ذلك عمليات سياسية واجتماعية مركبة، لكن النظرة الوحيدة، المنغلقة، هي أنهم لا يرون الماضي كلوحة مليئة بالتناقضات، فهي ليست فردوساً.
كل شيء فيه تناقض، وكل شيء سيئ فيه بذرة خير، وصراعات العرب في القديم موجودة وهم ليسوا خارج التناقضات، والتطور الإسلامي مليء بالتناقضات التي لم يستطع أن يحلها كلها، كما أن التطور الغربي المعاصر مليء بالتناقضات، والأمم تنمو عبر التناقض، تجمع جوانب إيجابية صغيرة وتراكمها، حسب قدراتها الاقتصادية والثقافية.
كان العديد من المثقفين العرب في الماضي يبحثون عن عالم بلا تناقضات، فيرون السماء والكواكب كمكان يخلو من الصراع، فيحاولون التخلص من أجسامهم، التي يعتبرونها أقفاصاً لأرواحهم، لكي تطير هذه الأرواح نحو الحديقة السماوية التي لا صراع فيها!
ولم يختلف الوعي السائد العربي حالياً عن ذلك، حيث يغدو له الماضي كالجنة التي تخلو من التناقض، كالواحة التي تهفو إليها روحه المعذبة من أسر المادة الحديثة، مثل الكهل الذي يحن لطفولته، ولهذا يريد الوعي السائد آراءً لا تناقض فيها، ولا تنمو، وتتعدل، يريد ماركسيةً تخلو من الأخطاء، وأن تكون نقية، مقدسة، ويريد إسلاماً يخلو من التحول والتغيير ونقد الذات، يريد قومية صافية كالنبع يتوحد الفقراء والأغنياء فيها كأسرة رومانسية سعيدة، يريد مجتمعاً لا يعرف التناقضات والصراع، دون أن يدرك أن الكون كله صراع، ولكن الصراع الاجتماعي والثقافي والديني لا بد أن يجري بشكل حضاري تراكمي، تنمو فيه الإنجازات!
الثلاثة الكبار
يحتاج الشباب العربي إلى بعض الكبسولات الثقافية السريعة من أجل قراءة الخطوط الفكرية العريضة في العالم المتقدم، وأسباب تطور قدراته الاجتماعية والسياسية.
وقد اعتمد الغرب في تطوره حديثاً على ثلاثة مفكرين كبار لعبوا دور النقلة، والانعطافة الفكرية له، وهم تشارلس داروين مكتشف نظرية التطور، وكارل ماركس مكتشف نظرية فائض القيمة، وسيجموند فرويد مكتشف نظرية اللاوعي.
وليس المهم الآن هو تفنيد بعض جوانب أفكارهم، فقد تجاوزت الأبحاث العديد من أفكارهم، ولكن المهم أنهم وضعوا الأساس الفكري للمناهج العلمية في درس الظاهرات الطبيعية والاجتماعية والنفسية.
يتحد الثلاثة الكبار هؤلاء في اعتماد الدرس الطويل، والبحث المضني للوصول إلى حقائق التطور في حقول مختلفة، ومترابطة في كونها تكشف جوانب مختلفة من حياة الإنسان.
وكذلك في اعتمادهم على أنفسهم للوصول إلى هذه الحقائق، حيث كان اعتمادهم على جهدهم الذاتي الخاص، وشقهم طرقاً جديدة كانت مرفوضة من قبل مجتمعاتهم التي عاشوا فيها، بل تمت مناوأتهم ورفض أفكارهم لسنوات طويلة، غير أن تطور العلوم الاجتماعية والطبيعية قد أثبت صحة أفكارهم، وكون بحوثهم تصدر عن نزعات موضوعية وقراءات مدققة في الجوانب التي درسوها.
تعبر أبحاثهم عن ثلاثة مستويات لقراءة الإنسان، فداروين بحث عن تطور الأنواع، واكتشف ارتباط الكائنات النباتية والحيوانية في سلم من التطور، انطلاقاً من الأسماك التي بدلت عيونها الثلاث إلى عينين، وطورت أجهزة التنفس فيها، إلى الحيوانات البرمائية، إلى الحيوانات الثديية المتعددة.
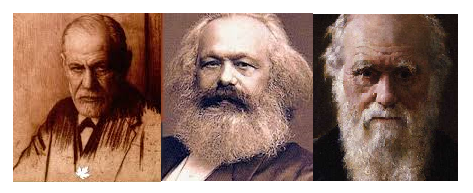
توجه داروين إلى بحث سببيات التطور العميقة التي رجح حدوثها في التكيف مع البيئة والصراع بين الأنواع المتخلفة والأنواع المتطورة، كما حدث للإنسان القرد وانتصار الإنسان العاقل عليه.
في اكتشاف داروين العلمي لتطور الإنسان ظهر عصر جديد من رؤية الحياة البشرية كظاهرات تخضع لقوانين وسببيات عميقة، وبهذا تم إعادة وضع الإنسان إلى بيئته، ورؤية الظروف الموضوعية التي شكلته، من أجل مزيد من التطور الخلاق المستقبلي في قدراته. وهذه العلمية في قراءة التطور البيولوجي انتقلت إلى صعيد التطور الاجتماعي والتاريخي، حيث اكتشف ماركس حلقات التطور التاريخية وأساليب الإنتاج التي مرت بها البشرية، ودرس على مدى ثلاثين سنة أسلوب الأنتاج الحالي وقوانين تطوره في البقعة التاريخية التي نضج فيها، وهي الغرب الحديث. ولكن ماركس لم يأخذ بعين الاعتبار كون الغرب كبقعة تطورية خاصة، لا تستطيع أن تصل إلى نهايتها التحولية، بدون العالم المتخلف التابع لها. وهكذا فإن انتشار أسلوب الإنتاج الرأسمالي عالمياً سيخضع سيرورة طويلة معقدة، لم تكن المواد العلمية المتاحة في زمنه إلا أدلة على الماضي وعلى حقبة الولادة لهذا الأسلوب من الإنتاج. وتعكس طبيعة الاستنتاجات السياسية له مشكلات الفقر والاستغلال للبروليتاريا الصناعية في زمنه. ومن هنا كان لينين يعبر عن مشكلات البلدان المتخلفة في محاولاتها للحاق بالتطور الرأسمالي، وقد بدا له ذلك كمحاولة أخيرة لصنع التاريخ.
أما فرويد فقد اكتشف قوانين اللاوعي، وهي تلك الطبقة المتوارية من العقل والشعور الإنساني، باعتبارها القعر العميق للنفس، ومن خلال منهج التحليل النفسي، حيث توجه إلى اختراق الطبقات الشعورية الفوقية للوصول إلى جذور الأزمات في الحياة الشعورية وأسباب الاضطرابات. وإذا كان قد اعتبر العامل الجنسي بمثابة العامل الوحيد الكلي، إلا أن هذا لا يقلل من شأن اكتشافه، الذي فتح أفاق الدراسات النفسية العميقة على مصراعيها، وبهذا تكون الأنسانية قد وصلت إلى الاكتشافات الكبرى لفحص جذورها البيولوجية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية.
الماديةُ والعلوم
في إنتاجِ دكتاتوريته الفردية يصعدُ لينين صراعَهُ ضد التعددية في الحزب، فيقسمهُ، ويصعدُ صراعَه ضد التنوع الديمقراطي في الغرب فيغدو الغرب برجوازياً لا بد له من شيوعية نافية له بكليته.
لكنه أيضاً يتوغلُ في مجال العلوم ويواجه تعددَ المدارس والتيارات الفلسفية المثالية العقلانية والمادية التجريبية من أجل إكتساح المادية الجدلية للمسرح الفكري. لكن أية مادية جدلية لديه؟
ظهرت في أواخر وأوائل القرن العشرين مدارس وحركات علمية عديدة لا تنطلق من المادية الجدلية بل من وعي علمي مختبري ومن غوص تجريبي في العقل ومن إستخدام اللغة في تحليل منتجات العلوم الطبيعية.
كانت مدرسة(التجريبية المنطقية) تتوجه نحو دراسة الظاهرات الطبيعية بأشكالٍ جزئية تجريبية، حيث تفصلُ الظاهرةَ العامة عن كلية الطبيعة، وتدرس عناصر التجربة، لاستخلاص نتائج موثقة.
تعارضُ هذه المدرسةُ أفكاراً ومسلمات إطلاقية من أجل أن تموضع الدراسة، وتحللَ الشيءَ أو الظاهرة، ولهذا رفضت مفاهيم مثل(المادة) و(الجوهر) معتبرة إياهما آراءً قديمة غير نقدية.
(إن اللون هو موضوعٌ فيزيائي إذا أخذنا بعين الاعتبار تبعيته لمصدر النور الذي ينيره للألوان الأخرى والحرارة والمكان الخ، ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار تبعيته لشبكية العين فأمامنا موضوع نفساني إحساس).
إن التجريبية المنطقية تقوم بدرس هذين الجانبين المواد والأشياء عبر صلاتها بالأحساس والجهاز العقلي البشري:
(إن الصلة بين الحرارة والنار تخص الفيزياء في حين أن الصلة بين(العناصر) وبين الأعصاب تخصُّ الفيزيولوجيا، ولكن لا هذه الصلة ولا تلك توجد بمفردها بل توجد كلتاهما معاً).
هذا ما يقوله الفيلسوف الإلماني ماخ في القرن التاسع عشر والذي ينقله لينين في كتابه(المادية والنقد التجريبي) ص 53، دار التقدم، موسكو.
فيقسم النقدُ التجريبي عمليةَ المعرفةِ المتأتية من العلوم إلى عناصر شيئية، وعناصر تفكيرية.
ويقول مفكر روسي موجزاً هذا(الإحساس مُعطى لنا أصدق من الجوهرية). بمعنى أن المطلقات هي خارج عملية البحث والتحليل للأشياء.
يعبرُ لينين عن إختلافه بطرق هجومية حادة ويقول محدداً وجهة نطره:
(يجب القول إن كثيرين من المثاليين وجميع اللاادريين.. يلقبون الماديين بالميتافيزئيين لإنه يخيل إن الأعتراف بوجود عالم خارجي مستقل عن إدراك الإنسان يعني تخطي حدود التجربة. وسوف نتكلم في حينه عن هذه التعابير وعن خطئها التام من وجهة نظر الماركسية)، ص 64.
لا يحلل لينين بدقة مسألة وصف الماديين بالميتافيزيقية هنا، ويخلطُ بين(إن الأشياء مستقلة عن وعي الإنسان بالمطلق)، وبين أن الأشياءَ ليست مسقلةً عن وعي الإنسان النسبي.
إن إنفصالَ الأشياء والطبيعةِ عن الإنسان هو أمرٌ موضوعي، لاجدال فيه، ولكنها ليست مستقلة عن وعي الإنسان التاريخي حين يتعامل معها ويحللها ويحاول إكتشافها.
وهكذا كان العلماء القدماء لا يفصلون أفكارهم وعقائدهم عن تحليل المواد، في حين وصلت العلوم بين القرنين 19و20 إلى عمليات متقدمة لفصل الوعي الذاتي للباحث عن المادةِ المدروسة.
ومن الممكن بهذا أن يقعَ الماديون في عالم الغيب الاجتماعي السياسي كما سيحدثُ للينين نفسه.
ومن هنا تتعاظمُ أهميةُ هذه القراءة للاحساس، ولتحول الانطباعات إلى معرفة، والتركيز على التجربة، التي لها أدوات ومستويات وتطورات في أجهزتها والتي تغدو ملغيةً لمعلوماتٍ وآراء سابقة نظراً لهذه الصلة بين المُعطى والتجربة.
لهذا تغدو العلومُ الطبيعيةُ منفصلةً عن الفلسفات والأديان والآراء المسبقة، وتغدو الفلسفات مستفيدة من خلاصات هذه العلوم ومستثمرة لها في وجهات نظرها.
من الممكن أن يكون هؤلاء الباحثين مثاليين ودينيين وماديين من مختلف التيارات، بسبب أن نشؤ العلوم في الغرب جاء من وعي مسيحيين ويهود ومؤمنين عامة، وهؤلاء حاولوا الارتقاء بالعلوم وعدم الاصطدام مع أديانهم وحجموا دلالات ونتائج العلوم وربطها بالصراعات الاجتماعية. لكن لينين ينطلق من رؤية حادة لإزالة الأديان والإستغلال بدون وعي علمي حقيقي، فيؤدي لتجربة مغايرة لما يريد.
خذ مثلاً ما يقوله لينين نفسه عن الأثير وعلاقته بالوعي:
(وهذا يعني إنه توجد خارج عنا، بصورة مستقلة عنا وعن إدراكنا، حركة للمادة، مثلاً، موجات الأثير ذات الطول المعين والسرعة المعينة، التي يولد في الانسان، بتأثيرها في شبكة العين، الإحساسُ بهذا اللون أو ذاك)، ص 54.
إن حركة المادة العامة المجردة هذه صحيحة التأثير غير أن(موجات الأثير) هذه غير موجودة في الطبيعة نفسها، أي أن هذا المصطلح من مفردات مدرسة علمية قديمة تم تجاوزها فلم يعد هناك شيءٌ أسمه موجات الأثير! لقد جرت تجارب علمية في أواخر القرن التاسع عشر أثبتت غياب هذا المُسمى، وبدأت نظرياتٌ علمية جديدة، ولكن مع غياب متابعة لينين:
(لقياس سرعة الموجات الكهرومغناطسية، قام ميكلسون ومورلي بإجراء تجربتهما الشهيرة سنة 1881وقد كانت هذه التجربة من أشهر التجارب في القرن التاسع عشر، والتي أدت إلى ثورة علمية لأن نتائجها كانت تعاكس تماما أفكار الباحثين المؤيدين لفكرة الأثير).
بطبيعة الحال إن العديد من باحثي النقدية التجريبية مثاليون ومحافظون وبينهم باحثون مناضلون في نقد وتحليل العالم الطبيعي والاجتماعي كذلك، لكن التعددية وإستثمار العلوم ونتائجها وتطويرها بالنقد يخلق شبكات تحليل واسعة للحياة في مختلف جوانب المعرفة.
يولي لينين أهميةً كبيرة لرجل الدين باركلي بإعتباره مشابهاً بشكل كلي للعلماء الفزيائيين والمنظرين النقديين التجريبيين، أصحاب هذه الفلسفة الجديدة التي قام لينين بمواجهتها في سنة 1908 في كتابه(المادية والنقد التجريبي).
(إن بريكلي يقول بكل جلاء إن المادة(جوهر لا وجود له)، ص 21.
يعتبر لينين ذلك بمثابة(الهجوم المقدس على المادة)!
إن رجل الدين المثالي هذا في تصوره يماثل أرنست ماخ الباحث من القرن التاسع عشر الفيزيائي المعروف.
لكن ثمة فرق هائل بين القس بيركلي والعالم ماخ!
فمن هو بريكلي هذا؟
جورج بيركلي (مارس 1685 – 14 يناير 1753) كان فيلسوفًا بريطانيًا-إيرلنديًا وأسقفا أنجليكانياً يعتبر من أهم مساندي الرؤية الجوهرية في القرن الثامن العشر الميلادي، ادعى بيركلي انه لا يوجد شيء اسمه مادة على الإطلاق وما يراه البشر ويعتبرونه عالمهم المادي لا يعدو أن يكون مجرد فكرة في عقل الله. وهكذا فأن العقل البشري لا يعدو أن يكون بيانا للروح. قلة من فلاسفة اليوم يمتلكون هذه الرؤية المتطرفة، لكن فكرة أن العقل الإنساني، هو جوهر، وهو أكثر علواً ورقياً من مجرد وظائف دماغية، لا تزال مقبولة بشكل واسع. آراء بيركلي هُوجمت، وفي نظر الكثيرين نُسفت)، موسوعة ويكيبيديا.
إذن بيركلي صاحب رؤية دينية متطرفة ألغى من خلالها العالمَ الموضوعي، وأعتبرهُ مجردَ فكرةٍ إلهية، وهو إمتدادٌ للعصور الوسطى والوعي الكَنسي التقليدي، ولهذا فهو يختلفُ إختلافاً كبيراً عن إرنست ماخ الذي عاش في القرن التاسع عشر باحثاً:
(ماخ، إرنست (1838 – 1916م) فيزيائي وعالم نفسي نمساوي درس حركة الأجسام بسرعتها القصوى خلال الغازات، وطوَّر طريقة دقيقة لقياس سرعتها معبرًا عنها بسرعة الصوت. وتعتبر هذه الطريقة مهمة خاصة في مشاكل الطيران الأسرع من الصوت. ظل عمل ماخ مبهماً إلى أن بدأت سرعة المركبة الفضائية تقترب من سرعة الصوت. وبعد ذلك استُخدم مصطلح رقم ماخ مقياساً للسرعة.)، المصدر نفسه.
وهو(يـُذكرُ باسهاماته في الفيزياء مثل رقم ماخ ودراسة موجات الصدم. كفيلسوفٍ للعلوم، فقد كان له تأثير كبير على الإيجابية المنطقية ومن خلال انتقادهِ لنيوتن، الذي مهّد لنسبية أينشتاين).
تتعدد وجهات نظر لينين تجاه ماخ ورؤيته، فيقول (التصور العام للماخيين ضد المادة) ص16،( الأسقف بركلي يساوي الماخيين)، ص35، وأتباعه يحاولون(تمرير المادية خلسة!)، (حاول أن يميل صوب المادية).
إن علماء الطبيعة يقومون بتنحية المُسبقات المختلفة، ومنها الأفكار، والتصورات القديمة عن المكان والزمان والمادة، وقد يقعون في أخطاء فكرية في هذا الهدف، ولكنهم يلجأون لذلك من أجل البحث العلمي، وعملية التنحية تبدو للينين بمثابة خيانة، ومن هنا يقوم ماخ بالبحث الجزئي المتغلغل في الظاهرة المدروسة للوصول إلى معرفتها والسيطرة عليها تقنياً، ثم يقوم بإختراعاته الكبيرة لكن فهمه النظري المادي الجدلي محدود.
(إن افيناريوس ينعتُ بالبحث المطلق ما يعتبرهُ ماخ صلة (العناصر) خارج جسمنا، وينعت بالنسبي ما يعتبره ماخ صلة العناصر التابعة لجسمنا)، المادية ص61.
إن افيناريوس هو عالمٌ مماثلٌ لماخ أقتربَ من رؤيته، وهو يعتبر الطبيعة التي هي العناصر خارج الجسم وبالتالي هي مطلقة، ولن تكون هنا في مجال البحث، لكن العناصرَ التي تدخلُ البحثَ هي متأثرة بوعينا ومستوى إدراكنا فهي نسبية.
كانت ثمة ثورةٌ علميةٌ تجري في أوربا من أجل الإطاحة بمفاهيم الفيزياء التقليدية، ومن أجل تصور جديد للمادة والكون، وهو تصورٌ متراوح متذبذب جزئي محدود لدى كل من ماخ وافيناريوس لكنه يظهرُ بصورته الكبيرة المادية الجدلية لدى انشتاين.
إن التجريبية النقدية المرفوضة عن لينين كانت تغيرُ العلومَ، لكنه كان لا يزالُ مع فكرة موجات الأثير، التي قامتْ تجربةُ العالِمين ميكلسون ومورلي بدحضها، سنة 1881 كما ذكرنا آنفاً في حين كتبَ لينين كتابَه سنة 1908، وطبعَهُ مرة أخرى بعد الثورة الروسية دون تغيير في فهمهِ لموجات الأثير، فتلك التجريبية أكدت أهمية دور العلماء الشخصي وتغييرهم لآراء سائدة مُسّبقة، قَبلية.
في مقابل واحدية الحزب المطلقة وهيمنة الدولة المطلقة يجري كذلك جعل المادية الجدلية مهيمنةً كلية، لكن الدكتاتورية هنا مُصّدعة للعلوم الطبيعية والاجتماعية على نحو خاص.
تتكشف في المساواة بين بريكلي والماخيين والتجريبيين المنطقيين عدم فهم لينين للتطور الاجتماعي الفكري العلمي ومراحله التاريخية ومسائل الديمقراطية وتعددية الاجتهادات الفكرية والفلسفية، ففيما يعكس بيركلي رؤية دينية صوفية رجعية يقوم علماءٌ من الفئات المتوسطة بتطوير العلوم مجتنبين الدينَ والمادية الجدلية الجامدة وقتذاك.
الخطوط العريضة لظهور العلوم
لقد كان تطور الرياضيات في العصر العباسي ملحوظاً في الانتقال من نمط الحساب باليد إلى الحساب العقلي ، وكان هذا يتطلب تبدلاً للأرقام القديمة بمختلف صيغها ، حيث كانت هذه الأرقام المثقلة بالحروف والإضافات تعجز عن متابعة العمليات الكبرى في العد الكمي ، فكانت الأرقام الهندية ، من خلال صيغتيها المشرقية والمغربية ، هي البلورة للوعي الكمي المتزايد لمتابعة العمليات الحسابية المركبة الواقعية ، وكان اكتشاف [ الصفر ] هذا الكم المعدوم ، إنجازاً رياضياً أكثر منه فلسفياً ، لأن العدم الكمي سيؤخذ ككم سلبي متصاعد وليس كمظهر آخر للوجود .
إن تحول أي رقم من الأرقام من الواحد إلى التسعة ، إلى خانات أكبر ، تضيف إلى الرقم الأولي كماً لا نهائياً ، يغدو تحولاً نوعياً للأرقام عبر قدرتها على عكس العمليات المعقدة في الإحصاء الكمي من جانبيه الإيجابي والسلبي .
وتعطينا مسألة دخول الأرقام الهندية إلى الرياضيات العربية فكرة مبسطة عن تداخل العمليات التجارية والثقافية بالعلوم ، فعبر تنامي التجارة في العالم الإسلامي ، وبينه وبين قوى العالم المدنية وقتذاك ، وسيادة المعيار الذهبي والفضي في المشرق والمغرب الإسلاميين ، راح الحساب اليدوي يتحول إلى حساب حديث ، [ فباستخدام النظام العشري – بما فيه الصفر – واستعمال الكسور ، أصبح من السهل إجراء العمليات الحسابية ، مهما تعقدت وتشابكت ، وأمكن تركيب أي عدد سواء أكان كبيراً أم صغيراً ، لا فرق أن يكون عدداً صحيحاً أو كسوراً من عدد صحيح ] ، (3) .
إن الأعداد الصحيحة والكسور ، وتراكيبها المتداخلة تشير إلى التحليل المتنوع المتزايد للكم في شكله المعروف ، أي غير المجهول ، والانتقال من كمه الإيجابي إلى كمه السلبي ، والجمع بين الجانبين ، والقيام بعمليات متداخلة منهما .
ثم تنتقل الرياضيات إلى المستويات الأكثر تركيباً عبر الجبر ، فهنا يصبح الكم المجهول واستخراجه من الكم المعلوم ، طريقة رياضية أخرى للحساب المتوغل في العمليات المجردة .
إن الخوارزمي الُمحتضن من قبل الخليفة المأمون هو الذي قام بهذه الاكتشافات عبر استفادته من الثقافتين الهندية والفارسية ، فيضيفُ ذلك إلى الثقافة العربية عامة ، في القرن الثاني الهجري حيث تجري التطورات الأكبر في ميدان اللغة والثقافة ، فتغدو الرياضيات هي أحد فروع العلم الأكثر استجابة للتطورات ، بحكم تجريديتها وعدم ارتباطها الملموس الواسع بالمادة الطبيعية والاقتصادية ، وقدرتها على النمو المجرد .
ويجري هذا عبر الارتباط كذلك بالثقافة اليونانية التي قدمت المواد الأولية البسيطة في الحساب والجبر ، غير أنها قدمت المادة الأغزر عبر [ الهندسة ] ، فصارت الهندسة الأقليدية مترجمة ومستوعبة عربياً بشكلٍ واسع ، وبدون إضافات كبيرة .
إن الهندسة الأقليدية المركزة على المكان وأبعاده الثلاثة ، ستغدو إضافةً هامة لفرعي الرياضيات السابقين وهما الحساب والجبر ، كما ستدخل في تكوينهيما العضويين ، فتتشكلُ عمليةُ نموٍ مركبة .
لكن الهندسة الأقليدية بتركيزها على أبعاد المكان الثلاثة ، ستعطي الفلسفة أبعاداً محدودة وتقيدها في هذه الأبعاد الظاهرة المتناهية .
وإذا كان الوعي العلمي منذ القرن الهجري الأول أخذ يطرقُ ، ليس كم المادة فقط ، بل أيضاً محتواها الداخلي كيميائياً وفيزيائياً فإنه أخذَ منذ القرن الثاني والثالث الهجريين يندفعُ بقوة لسبر أغوار المادة .
إن الكيمياء والفيزياء أخذتا تتطوران مع تنامي الحرف الصناعية ، حرف الزجاج وصهر المعادن والنسيج الخ ..، وهي الحرفُ التي ازدهرت في زمن الدولة العباسية الأول ، وظهر عدةُ علماء في هذا الزمن كجابر بن حيان في الكيمياء خاصةً :
[ أخذ جابر مادةَ الكيمياء – كما هو معلوم – من مدرسة الإسكندرية التي كانت تقولُ بإمكانية انقلاب العناصر وتحولها بعضها إلى بعض . وأخذ مع هذه الكيمياء فيضاً من الفلسفة الهيلينية والآداب السحرية والتصوف الشرقي والروحية الإيرانية ] ، (4) .
إن جابر بن حيان الذي لم يرتكز على مساندة الدولة في أبحاثه ، بل عبر ارتباطه بالإمام الشيعي البارز جعفر الصادق ، وهكذا كان عمله عبر جهده الفردي وفي فضاء الفكر الإشراقي المعارض ، ومن هنا تلونت استنتاجاته العلمية بدلالات إيديولوجية خاصة .
إن جابر بن حيان في سبيل الوصول إلى صناعة الذهب ، راح يلغي الأفكارَ المتجمدة عن الماهيات الثابتة للأشياء ، من أجل الوصول إلى ميزان [ الطبائع ] ، [ فمن عرف ميزانها عرف كل ما فيها وكيف تركبت ] ، (5) .
إن عمله دخل في تحولات المواد فاكتشف مواداً كيمائية جديدة ، والصناعة هنا تلعبُ دوراً تحويلياً إيجابياً ، فإضافة إلى اكتشافه سلسلة من المواد الكيمائية الجديدة :
[ عرف صناعة استخدام ثاني أوكسيد المنغنيز في صناعة الزجاج ( لإزالة اللون الأخضر أو الأزرق الذي يشوه الزجاج ) . ] ، (6) .
ولجابر بن حيان مجموعة كبيرة من الأبحاث والاكتشافات للمعادن ، (7) تعبر أغلبها عن عمليات صهر وتغيير وتركيب للمعادن ، ويتركز منهجه الفكري على الجمع بين الملاحظات العلمية الدقيقة وبين إقحام الأفلاطونية في البحث العلمي .
وهو يدعو إلى اكتشاف طبائع الأشياء وموازينها ، وكما يقول أحد الباحثين عنه بأن [ العملية الكيماوية عند جابر بن حيان حالة من حالات التأويل ، أي إخفاء الظاهر وإظهار الباطن . إنها عملية نفسية روحية ترمز إلى ارتداد النفس إلى ذاتها ] ، (8) .
إن التناقض بين الجانبين العلمي والإيديولوجي لا يمنع الاكتشافات العلمية لديه وتوصله إلى تركيبات موضوعيةٍ للمادة التي وصل إلى سببياتها الجزئية ، وذلك لأن البحث عن باطن المادة ، عن روحها ، هو بحث عن قوانينها ، مثلما تفعل الحركة الباطنية في البحث عن الباطن في النص الديني ، فتبحث عن الباطن في الواقع وعلاقاتها بالناس .
وإذا تعجز الحركة الباطنية عن الوصول إلى القوانين العامة للتطور والصراع الاجتماعيين ، فإن جابر بن حيان يعجز عن الوصول إلى القوانين العامة لحركة المادة ، لكنه ينجح في اكتشافه قوانين جزئية لتغيرات المادة فيتمكنُ من استخراج الحديد الصلب من خاماته الأولى ، وقد حضّر مجموعةً كبيرة من المواد الكيمائية كأكسيد الزئبق وحمض النتريك الخ..
تبينُ مكتشفاتُ العربِ في الصناعة الإنجازاتَ التي قاموا بها والحدود التي وقفوا عندها ، فإذ تطوروا في صناعة المعادن فإنهم برعوا في صناعة الأسلحة التقليدية :
[ مزج العلماءُ العرب والمسلمون الذهب بالفضة ، واستخدموا القصدير لمنع التأكسد والصدأ في الأواني النحاسية . واستخدموا خبرتهم الكيمائية في صناعة العطور ، ومواد التجميل وصناعة الأقمشة والشموع ، واستخراج الزيوت النباتية ، وتركيب الأدوية ، وصناعة الفولاذ والأسمدة والصابون والزجاج والأواني الزجاجية والمرايا والمصابيح الملونة والبلور . ] ، (9) .
إن كلَ هذه الصناعات وثيقة الصلة بطابع التطور الاجتماعي الذي تهيمنُ عليه الأرستقراطيةُ والفئاتُ الغنية الأخرى ، حيث هي صناعاتٌ استهلاكية لهذه القوى الاجتماعية ، التي تبّذرُ الفائضَ الاقتصادي ، ولهذا فإن الفوائض لا تتوجه للبحوث العلمية أو لتغيير طابع الإنتاج الحرفي ، وهذا يجعل طابع الأبحاث في الكيمياء والفيزياء أغلبها فردياً محضاً .
ولهذا فإن توجه جابر بن حيان لاكتشاف الباطن ، أي لاكتشاف قوانين المادة ، على المستوى الطبيعي ، يعبر عن وعي سحري كذلك بالسيطرة التامة الخارقة على الطبيعة والمجتمع .
وقد سبق أن تناولنا فكر الكندي وإسهاماته في الكيمياء والفيزياء (10) ، ورأينا كيف أن اكتشافاته العلمية تظلُ كذلك في إطار جزئي تقني ، ولم تتحول إلى استنتاجات فلسفية كبيرة ، أي لم يقم بإدغام بحوثه العلمية في نظرة اكتشافية مادية ، مع تمازج هذه البحوث برؤى أسطورية كذلك .
أما في الفيزياء فقد كانت للمسلمين إسهاماتٌ متخصصةٌ متناثرة في علم السوائل وحساب أوزانها النوعية ، وفي الجاذبية ، وكانت لديهم آلات كثيرة للرفع كلها مبنية على قواعد ميكانيكية ، وكانت لديهم اكتشافات للبصريات والضوء وكيفية الأبصار ، نقلت علم الضوء إلى تحول كبير .
[ كما بحث المسلمون في كيفية حدوث قوس قزح ، وسرعة الضوء والصوت ، وعرفوا المغنطيس… وبالجملة كانت المعلومات عن الميكانيكا ، والبصريات والضوء والصوت وخلافها من مباحث علم الطبيعة مبعثرة لا رابط بينها ، وكانت تــُبحث من قبلهم من منظور يستندُ إلى المنهج العقلي والبحث الفلسفي وكان المغلوط فيها أكثر من الصواب ] ، (12) .
توضحُ هذه الفقرات السابقة ضعف الأبحاث في الطبيعة وعدم قراءة قوانين المادة الداخلية ، كما تشيرُ إلى الاستعاضة عن استغلال حركة المادة الداخلية والطاقة باستخدام الحركة الميكانيكية في الروافع ، وهو ما تجسد كذلك في علم الحيل .
إن عدم البروز الكبير في علمي الكيمياء والفيزياء واختلاط أولهما بعلم السحر ، يشير إلى هيمنة الوعي المثالي على العلوم وهو أمر معبر عن قوانين البنية الاجتماعية ، التي تتحكم القوى العليا في إنتاج الوعي وتحديد تطور أشكاله ، وهي كلها أمور متشابكة عرقلت تحول الحرف إلى صناعات .
ولهذا نرى أن علوم الطب والصيدلة والفلك تنمو بشكل كبير ، بسبب الصرف عليها من قبل الطبقات الحاكمة ، فالعلمان الأوليان يرتبطان بصحة هذه الطبقات وبقائها ، كما يرتبط العلم الثالث بسيطرتها ، حيث أن علم النجوم والفلك اعتبر دائماً مُلحقاً بالقصور ، متابعاً لحركة السماء والنجوم المسئولة في رأيهم عن أحداث الأرض وحظوظ البشر .
وفي الطب كان لا بد من البحث بموضوعية عن الأمراض ، وبإلغاء سلسلة طويلة من الخرافات ، وهنا تصبحُ المادةُ الجسمية بلا تدخلٍ خارجي غيبي ، ويتواجد فلاسفةٌ كبارٌ في داخل المباني الاستشفائية ، حيث تقوم هذه بحماية وجودهم الشخصي وتطور ممارستهم الفكرية المتنوعة ، ولا بد في هذه الحالة من تطوير التشخيص الموضوعي للحصول على نتائج مرضية للحكام والأمراء والأغنياء ، ورغم أن الأرواحَ والغيبيات مهيمنةٌ على الفضاء الفكري للمجتمع والتفكير ، إلا أنه لا بد هنا من اكتشافِ الأسباب الموضوعية لمشكلات الأجساد وتكويناتها ، فينفصلُ الجسمُ عن الروح ، ويغدو ذا قوانين مستقلة عن اللامادة ، مثله مثل بقية أشكال المادة ، لكن تبقى السيطرة الأساسية في الكون الثقافي الديني للسماء والأرواح والنصوص الدينية .
ولهذا فإن ثنائية الروح الجسد ، وثنائية السماء والعالم ، لا تعبران عن نقص مستوى العلوم فحسب ، بل عن الضرورة الحتمية لفحص الجسد والعالم بشكل موضوعي تتطلبه الضروراتُ الصحية والإنتاجية .
لكن هذا لا ينفي ، من جهة أخرى ، ضخامة وجود السماء وأفلاكها وكواكبها وعوالم الأرواح والنفس الكلية والعقل الفعال والعقول السبعة والعشرة الخ ..، وسيطرتها على عالم الجسد والمادة .
إن الطب وتابعه علم الصيدلة ينموان باتساعٍ كاشفين سلسلة طويلة من الأمراض والتكوينات العشبية والمادية العلاجية ، ولكن استقلال الروح وهيمنة الغيب يبقيان على علم النجوم والدين كملاذين من نقص هذين العلمين وغيرهما في سيطرة الإنسان على جسده ونفسه وواقعه .
الحرفية والرؤى الفكرية
انبثق معظمُ المفكرين والفلاسفة وممثلو الحركات الاجتماعية من الفئات الوسطى ، ولا يقود هذا الانبثاق بالضرورة إلى تعبير عن هذه الفئات ، فهذا يعود لمواقف هؤلاء المفكرين والفلاسفة .
إذا نظرنا لمعظم المنتجين المفكرين وجدنا بصمات الحرف والمناطق الريفية أو الفقيرة تعلم نشأتهم كالعلاف والنظّام والحلاج والإسكافي والغزالي والباقلاني الخ.. ، وتدل هذه النشأة كذلك على طابع الفئات الوسطى الصغيرة عادةً المنتجة والمطحونة ، وعلى المستوى التقني السائد ، وينعكسُ هذا المستوى التقني على طابع التفكير .
يقول الباقلاني وهو يثبت أولية الإله :
[ فوجب أن تكون صور العالم وحركات الفلك متعلقة بصانع صنعها ، إذ كانت ألطفَ وأعجب صنعاً من سائر ما يتعذر وجوده من صانع الحركات والتصويرات ] ، (13) .
إن دليلَ الصانع هو دليل تضربه الحركاتُ الدينية في إثبات الخالق ، وهو مستقى من طابع الحرف ، حيث لا توجدُ طاولةٌ أو بابٌ دون نجار ، فتغدو الطبيعة الموضوعية مثل الطبيعة المصنوعة بشرياً ، فكلتاهما لا بد أن تكونا مخلوقتين ، استنتاجاً من البشري المرئي على الغيبي غير المرئي ، وهذا المنطق الصوري ، يتوافق هنا مع صناعة يدوية تقوم بتركيب أجزاء المواد بعضها ببعض لإنتاج أداة ما .
إن المنطق الصوري هو منطق شكلي يقيس المتشابهات في شكلها الظاهري ، ويقيم تضادات لا تقبل التداخل ، ولا يعرف النمو النوعي المنبثق من تراكم سابق في المادة والأشياء ، ويستنتج من فكر المقابلة غير الجدلي استنتاجات كبرى متضادة كلياً ، والإنسان الحرفي الرجل هنا الذي صنع البيت وركب الباب ، ووضع القنديل ليضيء ليلاً ، عكس تصوراته على الكون وعملية خلقه ، فهو كالإله ركّبَ سقفَ البيت وصنع القنديل والكرسي والطاولة وجعل المرأة تابعة له ، وكل ذلك في عدة أيام ، ثم استراح في اليوم السابع ، (14) .
وتقوده معلوماتــُهُ الجديدة عن الكون إلى إدغامها بهذه الرؤية الحرفية وكما غدت السماء شكلاً للسلطة السياسية ، فكذلك صارت شكلاً للسلطة الفكرية عبر العلوم المنتجة بهذه الأدوات الفكرية .
إن فكرة الصناعة الحرفية البشرية تــُطرح على أكبر الأجسام وهو الكون كما تطرح على أصغر الأجسام . يقول أبو هذيل العلاف :
[إن الجسم يجوز أن يفرقه الله سبحانه ويبطل ما فيه من الاجتماع حتى يصير جزءاً لا يتجزأ ، وأن الجزء الذي لا يتجزأ لا طول له ، ولا عرض ، ولا عمق ، ولا اجتماع فيه ولا افتراق ، وإنه يجوز أن يجامع غيره ، وأن الخردلة يجوز أن تتجزأ نصفين ثم أربعة ، ثم ثمانية ، إلى أن يصير كل جزء منها لا يتجزأ ] ، (15) .
إن أبا هذيل يناقش قضايا عميقة ، ويبحث في قضايا تكوين المادة ، لكنه كما يحددُ سقفَ الكون بالسماوات السبع ، فهو يحددُ سقفَ الجزء الذي لا يتجزأ الذي لا بد أن يصلَ إلى حدٍ معين ويقف عنده ، وهنا يطرح [ الخردلة ] هذه النبتة الزراعية المنتجة بشرياً ، والتي يفلقها إلى أجزاء فيقف تكوينها الظاهري عند حد معين لا يتجاوزه .
إن أبا هذيل لا يمتلك مختبرات ولا أجهزة لكي يغوص في تكوين هذه الخردلة ، مكتفياً بنظره ، وتعطيه هذه القدرة الحرفية والإيمان الديني المسبق ، استنتاجات ليس عن تكوين الخردلة بل عن تكوين المادة عموماً . لقد قفز من الخردلة إلى المادة الكونية التي لا بد أن تقف عند حد معين .
بطبيعة الحال لو كان يمتلك تلك الأجهزة ، وهي تعبرُ عن عصرٍ آخر ، لربما غير من رأيه الديني الواقف عند ذلك المستوى الحرفي .
إن أبا هذيل يرى المادة وهي ساكنة ، جامدة ، مُـقطعة بالأصابع البشرية ، ومرئية بالنظر المجرد ، فلا يرى أنها متحركة ، وأن لها حركة داخلية غير مرئية ، ومن هنا قطع سيرورتها الطبيعية ، أي لم ير كيف كانت قبل ذلك كجزء من النبات ، وتطورت بقوانينه ، وأنها الآن وهي بين أصابعه تتحلل وتعود لجزئيات صغيرة غير مرئية .
وحتى لو أن الرائي هو النظّام فإنه سيرى الخردلة وهي تتجزأ ولكنه سيراها بشكل عقلي بأنها سوف تتجزأ إلى مالا نهاية ، بحكم وعيه العقلي المسبق ، في حين سيرى الكون واقفاً عند حد معين من النمو ، فتغدو اللانهائية في جهة واحدة . حيث لا تسعفه أدوات البصر للنظر إلى الكون البعيد .
وهكذا فإن المنتجين الفكريين ستكون آراؤهم العقليةُ واتجاهاتهم الفكرية متلونةً تجاه معرفة الأشياء ، لكن هذه المهن والمواقف ومدى قربها من الأشياء ، ستؤدي إلى أفكار أكثر تطوراً .
ولهذا فإن المهن التي يمارسها الفلاسفة قد تطورت ، فثمة مسافة بين أبي هذيل العلاف وبين ابن سينا ، ليس لأن الأول لم تكن لديه مهنة محددة ، وإنه كان شبه مقتلع من جذوره الاقتصادية و [القومية] ، وأن الآخر كان في بيئة اجتماعية أكثر تماسكاً وقوة وتجذراً [ قومياً ] ، وإنه كان صاحبَ مهنةٍ راسخة هي مهنة الطب التي يحتاج إليها الناس بشدة ، ليس هذا فحسب بل أنه كان أقرب إلى العلوم والمواد المدروسة ، فكان يقوم بالعلاج والتشريح ، وكانت تحيطه موادٌ ثقافية أكبر وأعمق ، أي كان العقل [ الفعال ] ، ليس المتواجد في السماء ، بل الـُمنتّج على الأرض والذي يمثل التراكم الثقافي ، ذا كثافة أكبر سمحت له أن يتوصل إلى نظرة أكثر عمقاً واتساعاً من أبي هذيل العلاف ، فأصبح العالمُ المادي لا نهائياً في سيرورته العامة ، ومسيطراً عليه إلهياً ، أي محكوم سياسياً من قبل مركزٍ ما . أي أنه قام بالجمع بين مادة خالدة ، وأبنية دينية متحكمة في الوجود البشري .
أي أن تطور الفكر الفلسفي لن يتوقف على المهن الحرفية فقط ، فهي وجهٌ بسيط يقدم مواداً أولية محدودة ، ولكنه يعتمد أيضاً على التطور الثقافي عامة الُمحتضن من قبل قوى اجتماعية واسعة ، تتراوح بين جذور قومية لم تتكشف بعد ، وفئات وسطى طامحة ، وقوى تقليدية لا تزال مهيمنةً وبقوة على الفضاء الاجتماعي .
وفي حين كانت علوم الكيمياء والفيزياء والرياضيات لا تجد اهتماماً حكومياً كبيراً كانت علوم الطب والفلك والهندسة تلقى ذلك الاهتمام ، وهو أمر ترسخ منذ العصر القديم .
فنجد دور العلاج والمستشفيات التي تقام في المدن يوضع على رأسها أطباء كبار . ومن سيرة الرازي نقرأ :
[ عـُين رئيساً لأطباء مستشفى الري ، ثم عهد إليه بتدبير مستشفى بغداد ] ، (16) ، كذلك أنشأ المأمون فريقاً لقياس محيط الأرض بسبب تضارب القدماء فيه فأراد [حسم هذا الخلاف والوصول إلى القياس الدقيق ، فأمر بعمل الآلات واختيار موضع لهذه المساحة ] ، ( 17) ، في حين لما أراد البيروني في زمنٍ ووضعٍ آخر أن يتحقق من دقةِ هذا القياس قام بعمل فردي شاق .
إن كلَ هذه الظروف الاجتماعية والثقافية المتداخلة قد جعلت العلومَ مشتتةً ، فاقتربت من قوانين حركة الأجسام الكبيرة الخارجية ، المتاح رؤيتها والتعامل معها ، في حين بقي الفضاء الخارجي وداخل المادة ، نائيين عن هذه العلوم .
كذلك فإن العلوم تبعت حركة السيطرة الاجتماعية وطبيعة الصرف السياسي ، فتجسدت التطبيقات لها في بناء القصور والمساجد والمستشفيات والصيدلة ومشروعات الري .
ولم تنمُ العلومُ الإنسانية غير الدينية وغير اللغوية والأدبية نمواً كبيراً بل بدأت في أواخر هذا العصر عبر ابن خلدون وتلامذته في الانفصال عن هيمنة العلوم الدينية وبدأت تستكشف قوانين الاجتماع والتاريخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصادر :
(1) : (سوسيولوجيا الفكر الإسلامي، محمود إسماعيل، مصدر سابق ، ص44، ج 3 ) .
(2) : ( راجع الفصول التي كتبت عن أسباب ظهور التفكير الفلسفي وأعمال الجاحظ والكندي في الجزء الثاني من هذا المشروع ) .
(3) : ( الجامع في تاريخ العلوم عند العرب ، الدكتور محمد عبدالرحمن مرحبا ، منشورات عويدات ، ط 2 1988 ، ص 388 ) .
(4) : ( المصدر السابق ، ص 315 ) .
(5) : (قول جابر بن حيان ، استناداً للمصدر السابق ، ص 316 ) .
(6) : ( المصدر السابق ، ص 320 ) .
(7) : ( راجع قائمة مكتشفاته في الصناعة الكيمائية في ص 462 من العلوم عند العرب في الموسوعة العربية العالمية ، مجلد 16 ، مصدر سابق ) .
(8) : ( الجامع في تاريخ .. ، ص 318 ) .
(9) : ( الموسوعة العربية العالمية ، ص 460 ) .
(10) : ( راجع الجزء الثاني من هذا المشروع ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، فصل الكندي ) .
(11) ( الموسوعة العربية العالمية ، ص 464 ) .
(12) : ( السابق ، نفس الصفحة ) .
(13) : ( مذاهب الإسلاميين ، عبدالرحمن بدوي ، 602 )
(14) : ( راجع العهد القديم ، سفر التكوين ) .
(15) : ( مذاهب الإسلاميين ، ص 182 ) .
(16) : ( الجامع في تاريخ العلوم ، ص 259 ) .
(17) : ( السابق ، ص 434 ) .
العلوم والإنتاج والفلسفة
لم يعرف العرب وهم في جزيرتهم شيئاً مهماً من العلوم الطبيعية والرياضية ، وقد حثهم الإسلام على دراسة ظواهر الطبيعة من كائنات وحيوانات ونبات ، وكذلك من ضرورة النظر داخل الإنسان وأجزائه وظواهره .
وقد بدأت الصلة بالعلوم عبر الترجمة النادرة في زمن الأمويين ، واتسعت في القرون التالية ، عبر العلاقة بالثقافة اليونانية ، وكذلك الثقافة الهندية ، اللتين غدتا المصدرين القريبين من الحضارة العربية، جغرافياً وتاريخاً .
وتتعلق إمكانيات التطور العلمي ليس فقط بالاحتكاك ولكن بالقدرة على الدراسة الموضوعية في ظاهرات الطبيعة ، أي أن يستطيع العقل تحليل الأشياء بدون عقبات أيديولوجية وسياسية .
ولكن القوى المهيمنة وقد اتخذت السقف الفكري الديني الذي ركبته على مستوى النظام السياسي ، معياراً لمدى توغل الوعي في قراءة الطبيعة ، حدت من تطور العلوم باعتبارها مضادة للدين ككل .
إن السقف السياسي – الفكري للنظام الاجتماعي ، يتحدد بهيمنة المركز على الملكيات الزراعية الواسعة ، وتأتي الحرف والتجارة ، تبعاً وكنتائج لهذه السيطرة على الزراعة وقوى إنتاجها ، ونظراً لأن الزراعة تقوم على ركود طويل لقوى الإنتاج ، وتبعية شبه مطلقة لقوى الطبيعة ، فكان هذا عائقاً أساسياً ومستمراً لتطور العلوم وبالتالي لتطور المجتمع والفلسفة .
ولهذا فإن تطورات العلوم تغدو متقطعة ، لارتكازها أولاً على حاجات الأرستقراطية الحاكمة من أبنية ومعالجة وصناعات ضرورية ومكملة لهذا البذخ .
إن السقف السياسي لتطور العلوم يغدو واضحاً بارتباطها اللامباشر بقوى الإنتاج ، فهي تغدو تابعة للعالم الزراعي / الحرفي المهيمن المتواري ، الذي يعيق تقدمها المتواصل .
لكن السقف السياسي للنظام يتواشج ويتداخل مع سقفه الديني ، فقد تركز الوعي الديني التابع للحكام هنا على الحفاظ على ذلك السقف الإنتاجي الراكد ، ولهذا فإن هيمنة هذا النظام السياسي الديني ، كانت تعني الحفاظ على مستوى من الفهم النصوصي المحدود والضيق للقرآن والسنة ، أي الحفاظ على مستوى تطور متدنٍ للعلوم ، خوفاً من اختراقه لسيطرتها على الحياة السياسية والاجتماعية .
ولهذا كان الفهم المتزايد تطوراً للقرآن والسنة ، يتعاضد والفهم المتزايد للفلسفة والعلوم . وكان الاثنان يشقان طريقاً لزحزحة تلك السيطرة السياسية الاقتصادية على قوى الإنتاج الزراعية .
وهي سيطرة واسعة من حيث الجغرافيا ، حيث الحدود الإمبراطورية ، لكنها سيطرة ضيقة من حيث القوة الطبقية ، فهي أرستقراطيات بغداد على وجه الخصوص ، ولهذا كانت الحركة التاريخية التالية هي حل هذا التناقض .
إن الحقبة الأولى من النهضة العربية الإسلامية المواكبة لزمن الدولة العباسية الأولى : 132 / 332 ، يتمثل في تصادم نزعتا التجديد والمحافظة بقوة شديدة .
إن القوى المحافظة تقوم بجعل ثقافة العرب البدوية وكأنها مطابقة لمستوى الإسلام وإمكانياته المعرفية . ولهذا تقوم بنقل ثقافة العرب اللغوية والأدبية والدينية بشكل حرفي من أجل عدم تطويرها من قبل الأمم المتحضرة المحكومة من قبل العرب . ويمكن أن نرى مدرسة الكوفة النحوية والحفاظ على عمود الشعر والارتباط الصارم بتقاليد العرب والنصوصية الفقهية الشديدة والتمسك بالأساطير والخرافات كتنويعات على هذه المحافظة ، التي ووجهت بعمليات تجديد وتفسير عقلي متنوع وكفاحات جماهيرية .
إن تطور الدولة العباسية هو ذاته قد فرض تقدم العلوم المختلفة في القرن الثاني الهجري ، ولكن ذلك يرتبط بمستوى الإمكانيات الموضوعية للتطور التي يحددها أسلوب الإنتاج .
وكان تشكل إمبراطورية واسعة بعاصمة هائلة هي بغداد ، قد أدى إلى تضخم عوائل الأشراف التي كثرت حاجاتها لبناء القصور وأدوات المتع والشفاء ، كما أدى إلى اتساع الفئات الوسطى التجارية والحرفية والإدارية والفقهية ، التي كانت لها هي الأخرى مستويات معيشة جيدة . وكل هذه التطورات المادية كانت بحاجة ماسة إلى تطور علوم الطب والصيدلة والرياضيات والهندسة والفيزياء والكيمياء.
وإذا كان للدولة مصلحة في إزالة الإيديولوجيات الوثنية والتعددية التجسيمية ، فإن هذا أوجد فضاءً فكرياً مساعداً كذلك على نمو العلوم الرياضية والطبيعية ، في حدودها الدنيا أولاً .
فلم تنبثق العلوم من قوى الإنتاج مباشرة ، بل عبر الترجمات من مصادر المعرفة الإنسانية المختلفة اليونانية والهندية والفارسية، ولهذا نجد في هذا العصر السالف الذكر والتوصيف ، العلماء الفرديين ذوي العلوم الوحيدة أو المتقاربة ، كالخوارزمي المتوفى سنة 232 هـ ( الذي صنف كتابه الهام في ” الجبر والمقابلة ” الذي أفاد منه سائر علماء عصره) ، (1) .
ويُلاحظ هنا إن هذا الطابع الفردي للعلم ، أي المتخصص في علم بعينه ، أو في علوم متقاربة ، قد سبق ظهور الفلسفة ، أي إن مقولات الفلسفة لم تدخل بعد في هذه العلوم ، سواء كان دخولها إيجابياً أم سلبياً ، لأن ظهور الفلسفة سيكون تتويجاً لتطور العلوم .
ولهذا كانت عملية نمو العلوم تتم بدوافع فردية وباجتهادات خاصة ، وبدون علاقة مباشرة بأجهزة الدولة ، فلا يكون لهذه العلوم سقف إيديولوجي ما ، لكن بعض العلماء لا يجد من إمكانية لتطور علمه بدون (رعاية) ما من قبل الدولة كما حدث للخوارزمي في هذا الزمن والأزمان التالية بشكل عام .
كما يُلاحظ في هذا العصر أيضاً ضخامة التقدم الذي حققته العلوم الإنسانية (الأدبية) ، بخلاف العلوم الرياضية والطبيعية التي كانت جنيناً داخل رحم المرحلة .
والعلوم الإنسانية المقصودة في هذا العصر هي العلوم الأقرب للثقافة ، كالنحو والصرف والبيان وقواعد الموسيقى ، نظراً للحجم الكبير من الثقافة العربية الدينية الخام المنقولة من عصر سابق ، والتي قام الوعي بالاشتغال عليها حفظاً ورصداً وتحليلاً .
كما أن العصر كان قريباً من المرحلة السابقة ، الإسلامية التأسيسية والأموية ، ولهذا فإن العلوم الطبيعية لم تحض بمشتغلين كثيرين في هذا الزمن .
لكننا نستطيع أن نلحظ لدى المفكرين فيه بدايات تفكير موضوعي في الكائنات والأشياء والحيوان والإنسان ، فالمعتزلة في طريق بحثهم عن مسئولية الإنسان عن أفعاله ، راحوا يفكرون في الأفعال البشرية وتوالدها ، وفي الطبيعة وأشيائها وفي التاريخ ومسئولية الإنسان فيه . وأبدع كبار مفكريهم ومنهم الجاحظ قراءة فيها الكثير من الملاحظات الدقيقة عن عالم الحيوان ، (2) .
إن صغر حجم العلوم الطبيعية ، بخلاف الرياضيات التي شهدت مولدها ونموها الكبير ، يعود لطبيعة الثقافة الأدبية والنظرية المهيمنة ، في هذا العصر ، ولبداية نمو التفكير النظري ، الذي سيبدأ فلسفياً مع الكندي في أواخر القرن الثاني الهجري وبداية القرن الثالث ، والذي هو يمثل زمن سقوط العصر العباسي الأول ، ذي الدولة المركزية ، ومجيء العصر العباسي الثاني، عصر الدويلات .



