إلياس بلكا's Blog, page 12
December 6, 2013
سلسلة التصوف السلفي (5): في الإخلاص وسجود القلب.
في الإخلاص وسجود القلب تأليف: إلياس بلكا.رأينا أن للعلم فضلا عظيما، لكن نية العالم والمتعلم معرضة للفساد. ذلك أن المشكلة الكبيرة هي صعوبة الإخلاص، فقد سئل واحد من كبار الصالحين عن أشد شيء عالجه في طريق التصفية والتحلية طيلة مجاهداته لعشرات السنين، فأجاب بأنه الإخلاص. ويفسر الشاطبي ذلك في كتابه الموافقات بأن النفس تجد صعوبة هائلة في القيام بشيء ليس لها فيه حظ، وشرط الإخلاص التام ألا يكون للنفس أي حظ.. وهذا صعب جدا، فهوى النفس قوي جدا لا يكاد يملك قمعه إلا النادر في الناس، وهي درجة (الإنسان الكامل) التي أشار إليها الحديث الصحيح: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا ثلاثة.. الحديث. لذلك كان بعض الصوفية يرفض القيام بأي أمر مهما كان بسيطا إذا لم تكن له فيه نية سليمة.. فهو يريد أن تكون حركاته وسكناته كلها لله خالصة.. وهذا كله صحيح وغرض مقبول كما بيّن ذلك الشاطبي إمام المقاصد. لذلك كان بعض الصوفية يقولون: آخر شيء يخرج من قلوب الصديقين: حب الجاه. ويحكي ابن تيمية عن أبي يزيد البسطامي أنه خاطب رب العزة في المنام، وسأله: يا ألله، كيف السبيل إليك. فقال له سبحانه: اترك نفسك وتعال.والعلم لا يخرج عن هذا الإطار.. فالقضية تؤول إلى الغايات ما هي، وما المطلوب منا أصلا في الدنيا؟وكثير ممن ارتفع من السلف والصالحين عاليا وفي المقامات عارجا كان سره هو الإخلاص، كما قال الإمام أحمد عن عبد الله بن المبارك: إنه ما ارتفع مقامه في الدنيا إلا بسريرة بينه وبين ربه لم يكن يعرفها أحد. وكما قالوا أيضا في الإمام مالك وما كان من تلقي الأمة له بالقبول والإمامة، لذلك بارك الله فيه وفي علمه وتآليفه، بينما ألف كثيرون موطآت عديدة، لكن لم يهتم بها الناس، واندثرت بعدهم.ونظر لصعوبة الإخلاص فقد اعتبره الشارع أفضل العبادات وأعلى الأعمال، كما في قوله تعالى: (قل آمنت بالله ثم استقم)، وهو معنى الإسلام في قوله: (إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين..)، وهو المعنى العميق أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال: لا إله إلا الله.. إشارة إلى إخلاص الأمر كله لله تعالى. والله سبحانه غيور لا يقبل أن يشرك به شيء، بل يحب من العبد أن تكون وجهته جميعها لوجه الله. ولعل هذه الصلة بين التوحيد والإخلاص هي سبب تسمية سورة قل هو الله أحد بـ: سورة الإخلاص، على القول بأن أسماء السور توقيف لا توفيق، كما هو مذهب الجمهور.والحلّ الذي أشار إليه الشاطبي أيضا هو أن يحرص المرء على سلامة نيته ما أمكنه ذلك، فإن كان لنفسه حظ من العمل فلا بأس به على أساس أن تكون النية الأكبر لله، بمعنى أنه لا بأس أن تكون للمرء نيتان إحداهما خالصة والأخرى نفسية، لكن تكون الأولى أصلية والثانية تابعة.. وهذا الحلّ هو الحل الواقعي الذي يمكن للناس بلوغه بالمجاهدة والمحاولة، أما الإخلاص التام فمجال شاق جدا للمحاولة والمطاولة، لكن لا سبيل لمعرفته، وهذا معنى حديث أنه يمكن للإنسان أن يعمل أعمالا كثيرة لا يكون لها يوم القيامة وزن، وأن بعض الأعمال القليلة هي التي تنجي صاحبها لثقلها في الميزان، وهي الأعمال التي كانت خالصة لله وحده. والمؤمن حين يعمل الطاعات لا يستطيع أن يميز بسهولة هذه من تلك، لذلك كان السلف دائم الخوف ولا يدري هل تقبل أعماله أم تُرد في وجهه. وعلى هذا وأمثاله يتنزل حديث النبي الكريم: القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فما شيء أشد تقلبا وتفلتا وتغيرا من القلب، وهو محل النية، كما قال النبي العظيم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.وقد أرشدنا الإسلام إلى أساليب لاكتساب الإخلاص، منها في حديث السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله: صدقة السرّ لدرجة أن يد الشمال لا تعلم ما فعلت اليمين، والرجل الذي ذكر الله في مكان خال لم يره أحد فبكى، والذي دعته امرأة ذات جمال فتعفف.. ونحو ذلك، ولذلك كان السلف يحرص مثلا على أن يصلي بالليل والناس نيام.. وقد روي أن الجنيد رحمه الله رُئي في المنام، فسئل عن حاله، وهو إمام الصوفية الذي مهّد علومها واصطلاحاتها، فقال: طاحت تلك الإشارات وذهبت تلك العبارات، ولم تنفعنا إلا ركيعات في جوف الليل.. لكن حتى الذي يسلك هذا السبيل على خطر، وهو أن يدخله العُجب بالنفس، فيرى نفسه كثير العبادة، بل ربما ظن نفسه من كبار المقربين.. فيرجع الأمر مرة أخرى إلى تجاذب النفس بين الإخلاص لله والإخلاص لنفسها وهواها، لذلك سمى نبينا الرياء بالشرك الخفي لأنه يدخل على النفس من حيث لا تحتسب.. وهنا لابد من توفيق الله للعبد، أعني أنه من دون رحمة الله تعالى لعبده وتقويته له وتقريبه منه.. من دون ذلك من الصعوبة بمكان أن ينجح المرء في صراع النيات هذا. وهذا من معاني ما جاء في عشرات النصوص عن هداية الله وتوفيقه وإعانته لعبده الصالح، وعن خذلانه وإضلاله لغيره: (ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا).. فالمقصود أن العبد يحرص على المحاولة الدائمة، فإذا عرف الله منه الإصرار والصدق.. جذبه إليه. وإذا جذبه إليه وأدخله حضرته القدسية، فرأى من الأنوار ما رأى، ومن آيات ربه ما قُدر له دون الورى.. فقد فاز واجتاز القنطرة، ولم يعد يُخاف عليه من الشرك ظاهره وخفيه، جليله ودقيقه.. وإن وقع كان يسيرا معفوا عنه، سرعان ما ينتبه له فيستغفر ويعود، لذا لا تخلو العبودية الحقة عن الاستغفار الدائم: كان خير الخلق يستغفر الله سبعين مرة.. والله أعلم، وهو سبحانه أجلّ وأحكم. جريدة الأخبار، ملحق دين وفكر، عدد 7 ديسمبر 2012 يتبع..
Published on December 06, 2013 15:32
December 3, 2013
سلسلة: آفاق جديدة في البحوث الإسلامية (12). الإصلاح الديني بين المسيحية والإسلام.
سلسلة: آفاق جديدة في البحوث الإسلامية (12).
إلياس بلكاأكتب هنا عن بعض القضايا المهمة التي تحتاج إلى جهود الباحثين والمؤلفين، خاصة من جيل الشباب.. فهي قضايا مهمة بالنسبة لحاضر الأمة الإسلامية ومستقبلها، بل إن نهضتنا المنشودة تقوم جزئيا على الدراسة العميقة والجادة لهذه المشكلات وأمثالها، وتقديم الحلول المناسبة لها: حلول تراعي الدين وقواعده، دون أن تغفل عن العصر وطبيعته...
إلياس بلكا
Published on December 03, 2013 11:52
November 29, 2013
سلسلة آفاق جديدة في البحوث الإسلامية (11). الإسلام وأدب الرعب.
سلسلة آفاق جديدة في البحوث الإسلامية (11).
الإسلام وأدب الرعب:
إلياس بلكا
رأينا في المقترح الأخير (ضمن السلسلة) عن البشرية الخائفة كيف أن مستويات الخوف في العالم اليوم جد مرتفعة، وكيف أنها على نوعين: مخاوف حقيقية وأخرى مصطنعة من طرف تجار الخوف.
واليوم نتحدث عن ظاهرة الإخافة، وليس الخوف، وهي التي تتعمد "إثارة الرعب"، خاصة من خلال الأدب والسينما... فصور الرعب تتجسد عبر مظاهر أربعة: خارقة، كالأشباح. أو طبيعية، كالكوارث والحيوانات الخطيرة. وبشرية، كالسحر والتحكم الجيني. ومادية، كالأشياء الجامدة حين تصبح متحركة... وهذه الصور تتمحور حول خمس قضايا رئيسة: الحيوانية، والشر، والآخر، والخروج عن الطبيعة، والقرين أو الصنو Double.. أي إن هذه الصور تمس بهوية الإنسان وشخصيته المستقلة.. ولعل هذا ما يعطي لهذا الأدب فعالية حقيقية أحيانا في إثارة الرعب.
ويعتمد الحكي من أجل إثارة الهلع على ترك المتلقي في حالة من الغموض وقلق الترقب، وذلك بالاعتماد على أساليب سردية تجمع بين الواقعي والمتخيل والممكن. ولذا نجد الروائي الأمريكي المعاصر ستيفن كينغ، وهو بارع في القصص المثير، يعتبر أن الأساس في هذا النوع من الحكي هو الإيحاء، لأنه يدفع بالقارئ إلى تخيل الفظاعة التي يخفيها عنه الكاتب.
لكن ما هو هدف قصص الرعب: هل هو التخويف أم التحكم في الخوف والسيطرة عليه؟ في هذا الإشكال رأيان: الأول يعتبر أن الغاية الأهم لهذا الأدب هي إثارة الرعب، إذن فهي مضرة. والثاني يرى أن لهذا الأدب وظيفة تنفيس المتلقي وتخليصه من مخاوفه عبر دفعه لتمثل الإرهاب المشاهد أو المقروء، كما لهذا الأدب دور أخلاقي في التنبيه على المخاطر التي تهدد الإنسان.
في الحقيقة يظل قائما سؤال وظيفة أدب الرعب، ولماذا يستهوينا ويعجبنا؟ وفي اعتقادي لا يمكن الحكم على هذا الأدب حكما واحدا، بل في الأمر تفصيل. فأدب الخيال العلمي مثلا غالبا ما يستبطن تحذيرا من مخاطر التطور العلمي والتكنولوجي ومن غرور الإنسان، فيؤدي وظيفة أخلاقية جيدة. من ذلك: رواية "فرانكشتاين" لماري شيلي، وبعض أعمال ويلز وستابلدون وكينغ. لكن بعض الأدب الآخر لا هدف له في الظاهر غير إرهاب القارئ أو المتفرج إلى أقصى حد ممكن، بل من الواضح أن بعض الكُتاب يتعمد ذلك ويجد متعة شخصية كبيرة في تصوير مجّاني للبشاعة والفظاعة... تصوير يغدو بمثابة الهدف الرئيس للرواية.
والإسلام يعترف بهذه الطبيعة الإنسانية القابلة للخوف، حتى القرآن الكريم يحكي لنا عن النار وأهوالها لنخاف عذاب ربنا. وفي الأحاديث أن بعض الظواهر الفلكية، كالبروق والرعود والرياح العاصفة.. بالإضافة إلى أدوراها الطبيعية المقرر في علوم الطقس والسماء، هي آيات يُخوّف الله بها عباده، لذا كان النبي عليه السلام إذا رأى شيئا من ذلك امتقع وجهه وتغيّر لونه..
والمطلوب من المؤمن أن يحقق في باطنه شعورين: شعور الرجاء في الله، وشعور الخوف من الله.. حتى اختلف العلماء أيهما أفضل للإنسان، بمعنى أيهما الأجدر أن يغلب عليه: الخوف أم الرجاء، بعد الاتفاق على وجوب تحلي المؤمن بهما معا..
إذن لا يمكن أن تخلو التربية في ضوء هذا من وسيلة الإخافة، لذلك يتحدث التربويون عن المكافأة والعقاب، وإن اختلفوا في نوعية العقاب.. لكنهم يتفقون على أن الطفل لابد أن يحذر من المنع ويطمع في الجزاء..
وواضح أن الدين يستثمر عاطفة الخوف لتحقيق أغراض تربوية نبيلة، وفي حدود معينة.. بحيث لا يجوز أن يصير الرعب هدفا في حد ذاته وغاية تُطلب لوحدها. وهذا معنى نهي النبي الكريم عن إخافة المسلم حتى بالمزاح.. كما جاء في الحديث الصحيح.. ونهيه أيضا عن الإشارة بسلاح إلى مسلم، فهذا لا يجوز، ونرى حوالينا مثلا أن بعض الناس يلعبون بالسكاكين يخوفون بها بعضهم بعضا.. بل توجد صناعة قائمة اليوم تتعلق بأدوات الرعب من أقنعة ورؤوس مقطوعة وأيد مفصولة ودماء تسيل.. هذا كله "لعب" مكروه بحسب ظاهر الأحاديث، ولعل البحث العلمي النفسي والتربوي يتعمق في الموضوع ويكتشف بعض أسرار هذا النهي النبوي.
إذن يظل هذا السؤال قائما: ما هي وظيفة أدب الرعب بالضبط، ولماذا يتعلق به الجمهور المعاصر، لدرجة أنه يوجد قطاع واسع من الناس المدمنين على مشاهدة أفلام الرعب، خاصة بأمريكا؟ بل إن الغربيين جعلوا للرعب عيدا خاصا، وهو الهالوين..
ولا يحسبن أحد أن الجواب عن هذا الإشكال أمر هيّن، ففي إحدى دراساتي الأكاديمية وصلت إلى سؤال شبيه بهذا، واحترت في الإجابة عنه كما احتار كثير من المختصين في علوم الإنسان: لماذا يُقبل الإنسان المعاصر على الفنون الخفية التي كان الظن عاما بأنها اندثرت مع عصر العلم والحداثة، كالتنجيم والروحية والسحر والتنبؤ بالمستقبل والغنوصية... ونحو ذلك؟
هذا كله يؤكد حقيقة اجتماعية ونفسية مهمة، هي أن الإنسان المعاصر كائن بالغ التعقيد على المستوى الفكري والنفسي والسلوكي.. كما قال ألكسيس كاريل: الإنسان... ذلك المجهول 1. يستوي في ذلك الإنسان القديم الذي كان يعيش في الكهوف، والإنسان المعاصر الذي يدخل السينما ليأخذ جرعة قوية من الرعب.. وهو يأكل ويشرب.. وقد يدخّن أيضا.
هذا كله يصلح أن يكون موضوعا لأبحاث علمية.. في شعب الدراسات الإسلامية والنفسية والتربوية والاجتماعية.. أو أبحاث حرة.
-عنوان الكتاب الشهير للمفكر الفرنسي: L’Homme, cet inconnu
الإسلام وأدب الرعب:
إلياس بلكا
رأينا في المقترح الأخير (ضمن السلسلة) عن البشرية الخائفة كيف أن مستويات الخوف في العالم اليوم جد مرتفعة، وكيف أنها على نوعين: مخاوف حقيقية وأخرى مصطنعة من طرف تجار الخوف.
واليوم نتحدث عن ظاهرة الإخافة، وليس الخوف، وهي التي تتعمد "إثارة الرعب"، خاصة من خلال الأدب والسينما... فصور الرعب تتجسد عبر مظاهر أربعة: خارقة، كالأشباح. أو طبيعية، كالكوارث والحيوانات الخطيرة. وبشرية، كالسحر والتحكم الجيني. ومادية، كالأشياء الجامدة حين تصبح متحركة... وهذه الصور تتمحور حول خمس قضايا رئيسة: الحيوانية، والشر، والآخر، والخروج عن الطبيعة، والقرين أو الصنو Double.. أي إن هذه الصور تمس بهوية الإنسان وشخصيته المستقلة.. ولعل هذا ما يعطي لهذا الأدب فعالية حقيقية أحيانا في إثارة الرعب.
ويعتمد الحكي من أجل إثارة الهلع على ترك المتلقي في حالة من الغموض وقلق الترقب، وذلك بالاعتماد على أساليب سردية تجمع بين الواقعي والمتخيل والممكن. ولذا نجد الروائي الأمريكي المعاصر ستيفن كينغ، وهو بارع في القصص المثير، يعتبر أن الأساس في هذا النوع من الحكي هو الإيحاء، لأنه يدفع بالقارئ إلى تخيل الفظاعة التي يخفيها عنه الكاتب.
لكن ما هو هدف قصص الرعب: هل هو التخويف أم التحكم في الخوف والسيطرة عليه؟ في هذا الإشكال رأيان: الأول يعتبر أن الغاية الأهم لهذا الأدب هي إثارة الرعب، إذن فهي مضرة. والثاني يرى أن لهذا الأدب وظيفة تنفيس المتلقي وتخليصه من مخاوفه عبر دفعه لتمثل الإرهاب المشاهد أو المقروء، كما لهذا الأدب دور أخلاقي في التنبيه على المخاطر التي تهدد الإنسان.
في الحقيقة يظل قائما سؤال وظيفة أدب الرعب، ولماذا يستهوينا ويعجبنا؟ وفي اعتقادي لا يمكن الحكم على هذا الأدب حكما واحدا، بل في الأمر تفصيل. فأدب الخيال العلمي مثلا غالبا ما يستبطن تحذيرا من مخاطر التطور العلمي والتكنولوجي ومن غرور الإنسان، فيؤدي وظيفة أخلاقية جيدة. من ذلك: رواية "فرانكشتاين" لماري شيلي، وبعض أعمال ويلز وستابلدون وكينغ. لكن بعض الأدب الآخر لا هدف له في الظاهر غير إرهاب القارئ أو المتفرج إلى أقصى حد ممكن، بل من الواضح أن بعض الكُتاب يتعمد ذلك ويجد متعة شخصية كبيرة في تصوير مجّاني للبشاعة والفظاعة... تصوير يغدو بمثابة الهدف الرئيس للرواية.
والإسلام يعترف بهذه الطبيعة الإنسانية القابلة للخوف، حتى القرآن الكريم يحكي لنا عن النار وأهوالها لنخاف عذاب ربنا. وفي الأحاديث أن بعض الظواهر الفلكية، كالبروق والرعود والرياح العاصفة.. بالإضافة إلى أدوراها الطبيعية المقرر في علوم الطقس والسماء، هي آيات يُخوّف الله بها عباده، لذا كان النبي عليه السلام إذا رأى شيئا من ذلك امتقع وجهه وتغيّر لونه..
والمطلوب من المؤمن أن يحقق في باطنه شعورين: شعور الرجاء في الله، وشعور الخوف من الله.. حتى اختلف العلماء أيهما أفضل للإنسان، بمعنى أيهما الأجدر أن يغلب عليه: الخوف أم الرجاء، بعد الاتفاق على وجوب تحلي المؤمن بهما معا..
إذن لا يمكن أن تخلو التربية في ضوء هذا من وسيلة الإخافة، لذلك يتحدث التربويون عن المكافأة والعقاب، وإن اختلفوا في نوعية العقاب.. لكنهم يتفقون على أن الطفل لابد أن يحذر من المنع ويطمع في الجزاء..
وواضح أن الدين يستثمر عاطفة الخوف لتحقيق أغراض تربوية نبيلة، وفي حدود معينة.. بحيث لا يجوز أن يصير الرعب هدفا في حد ذاته وغاية تُطلب لوحدها. وهذا معنى نهي النبي الكريم عن إخافة المسلم حتى بالمزاح.. كما جاء في الحديث الصحيح.. ونهيه أيضا عن الإشارة بسلاح إلى مسلم، فهذا لا يجوز، ونرى حوالينا مثلا أن بعض الناس يلعبون بالسكاكين يخوفون بها بعضهم بعضا.. بل توجد صناعة قائمة اليوم تتعلق بأدوات الرعب من أقنعة ورؤوس مقطوعة وأيد مفصولة ودماء تسيل.. هذا كله "لعب" مكروه بحسب ظاهر الأحاديث، ولعل البحث العلمي النفسي والتربوي يتعمق في الموضوع ويكتشف بعض أسرار هذا النهي النبوي.
إذن يظل هذا السؤال قائما: ما هي وظيفة أدب الرعب بالضبط، ولماذا يتعلق به الجمهور المعاصر، لدرجة أنه يوجد قطاع واسع من الناس المدمنين على مشاهدة أفلام الرعب، خاصة بأمريكا؟ بل إن الغربيين جعلوا للرعب عيدا خاصا، وهو الهالوين..
ولا يحسبن أحد أن الجواب عن هذا الإشكال أمر هيّن، ففي إحدى دراساتي الأكاديمية وصلت إلى سؤال شبيه بهذا، واحترت في الإجابة عنه كما احتار كثير من المختصين في علوم الإنسان: لماذا يُقبل الإنسان المعاصر على الفنون الخفية التي كان الظن عاما بأنها اندثرت مع عصر العلم والحداثة، كالتنجيم والروحية والسحر والتنبؤ بالمستقبل والغنوصية... ونحو ذلك؟
هذا كله يؤكد حقيقة اجتماعية ونفسية مهمة، هي أن الإنسان المعاصر كائن بالغ التعقيد على المستوى الفكري والنفسي والسلوكي.. كما قال ألكسيس كاريل: الإنسان... ذلك المجهول 1. يستوي في ذلك الإنسان القديم الذي كان يعيش في الكهوف، والإنسان المعاصر الذي يدخل السينما ليأخذ جرعة قوية من الرعب.. وهو يأكل ويشرب.. وقد يدخّن أيضا.
هذا كله يصلح أن يكون موضوعا لأبحاث علمية.. في شعب الدراسات الإسلامية والنفسية والتربوية والاجتماعية.. أو أبحاث حرة.
-عنوان الكتاب الشهير للمفكر الفرنسي: L’Homme, cet inconnu
Published on November 29, 2013 11:19
November 27, 2013
لغز الزمان
نشرت مجلة المعرفة - شهرية ثقافية تصدر من المملكة السعودية - هذا المقال بالعدد 93، تحت عنوان ما الزمان؟
يثير موضوع الزمان إشكالات لا تنتهي، دون حلها خرط القتاد والصعود إلى السماء. فهذا لغز قديم، بل هو من أقدم ألغاز الفكر والفلسفة، ومن أصعبها تناولاً وأعقدها حلاً. ومع ذلك لا شيء أقرب إلى الإنسان من الزمان، فوجوده نفسه ـ وما فيه من أحاسيس وأعمال ـ يقع داخل إطار الزمان. حاول أن تسأل نفسك هذا السؤال وأن تجيب عنه: ما هو الزمان؟
انظر أسفله، أو الرابط: http://www.almarefh.org/news.php?acti...
مجلة المعرفة/ العدد 93 / ما هو الزمان؟
إلياس بلكا :
يثير موضوع الزمان إشكالات لا تنتهي، دون حلها خرط القتاد والصعود إلى السماء. فهذا لغز قديم، بل هو من أقدم ألغاز الفكر والفلسفة، ومن أصعبها تناولاً وأعقدها حلاً. ومع ذلك لا شيء أقرب إلى الإنسان من الزمان، فوجوده نفسه ـ وما فيه من أحاسيس وأعمال ـ يقع داخل إطار الزمان. حاول أن تسأل نفسك هذا السؤال وأن تجيب عنه: ما هو الزمان؟
وقد فرض موضوع الزمان نفسه على العلم المعاصر، خصوصًا بعد ظهور الفيزياء النسبية، فهو اليوم من ألغازه الكبرى التي لم يستطع فك طلاسمها وأسرارها(1).إن الزمان بحر لا ترى له ساحلاً ولا تميز فيه وسطًا من طرف. لقد جعل بعضهم من المستقبل محور الزمن ونقطة ارتكازه، لكن كيف نعتمد على شيء لم يوجد بعد ولا يعرفه أحد. وكذلك الماضي فهو لا يوجد الآن، حيث انقضى وصار في العدم، وقال آخرون فليكن المرجع هو الحاضر، ولكن ما هو الحاضر؟ أليس مجرد معبر عابر بين الماضي والمستقبل، فهو ينفلت منا باستمرار، فليس له امتداد وثبات؟ إن هذا الحاضر قبل أن نفكر فيه يكون ـ في الواقع ـ مستقبلاً، ثم بمجرد أن ننتبه إليه يكون قد صار من الماضي موضوعًا للتأمل والفكر. يقول «وايتهيد»: إن ما نسميه الحاضر هو الجزء الحي من الذاكرة والذي له طابع التوقع(2).ومنذ القدم اختلف الفلاسفة في موضوع الزمان على رأيين:الأول يرى أنه لا وجود للزمان خارج الروح، فهو إحساس ذاتي لا علاقة له بالكون، ولذلك لا نستطيع أن نتمثل الزمان خارج أنفسنا(3). ومن أشهر القائلين بهذا الرأي القديس «أغسطين»(4).والثاني يرى أن الزمان حقيقة واقعية، لها وجودها المستقل، ومن ثم فإن الزمن واحد لا يختلف مهما اختلفت العوالم والحركات والأشخاص. ومن أبرز العلماء الذين ثبتوا هذه الفكرة: نيوتن، وكان يرى أن في الزمان بعدًا أو شيئًا إلهيًا(5).ومهما اعتبرنا الزمان إحساسًا ذاتيًا أو شيئًا واقعيًا، فإن مشكلة أخرى تظهر، وهي: كيف نفسر الزمان؟اعتبر أرسطو أن الزمن هو مقدار الحركة والتحول(6). وهذا التصور هيمن طويلاً على كثير من الاتجاهات الفلسفية، لكنه يثير إشكالات كثيرة بيّن ابن رشد بعضها: فنحن مثلاً نشعر بالزمان حتى حين نكون في الظلمة لا نتحرك. ولو كان الزمان هو حركة الأفلاك السماوية ما أحس به الإنسان الأعمى، أو كان نتيجة حركة معينة أخرى لم يكن للذي لا يراها أي إحساس بالزمان. ثم لو كان الزمن ثمرة أي حركة، غير حركة الأفلاك، لتعددت أنواع الزمان بتعدد أنواع الحركات(7).لكن روح هذا التصور الأرسطي انتقلت إلى بعض العلماء، خصوصًا حين ظهرت النسبية، فالحركة تحدث في مكان، أي في فضاء، وهذه الفيزياء أرست علاقة وطيدة بين الزمان والفضاء.الزمان في الفيزياء النسبية:الزمان هنا لا يوجد مستقلاً ومطلقًا، بل يرتبط بفضاء ما. فإذا تصورنا فضاءين مختلفين كان عندنا زمانان مختلفان. ولما كان الفضاء الأقليدي له أبعاد ثلاثة: الطول والعرض والعمق (إحداثياته x,y,z)؛ فإن الزمان المرتبط به هو بعد رابع (t). والعامل الذي يعادل بين الفضاء والزمن هو العنصر: C.وتوجد مجموعة من المعادلات تربط بين هذه العوامل كلها، منها: x4=ct ومنها: DS2= Dx2+ Dy2+Dz2-c2Dt2والعامل C هو السرعة القصوى، أي سرعة الضوء.ومن نتائج هذا النظر أن الزمن «تحول» إلى الفضاء، بل الفضاء نفسه يمكن أن «يتحول» ـ نسبيًا ـ إلى الزمان. كما أن الزمن يتمطط ويتمدد بالحركة(8).ولهذا اعتبر بعض المفكرين أن هذه الفيزياء تنفي الزمان، مثلها مثل فيزياء نيوتن. فهذا جعل الزمان من المطلق، فهو الحاضر الدائم، والنسبية ربطته بالفضاء ربطًا فيزيائيًا «ماديًا»(9).وأضرب للقارئ هذه الأمثلة لتقريب صورة الزمان في النسبية: لنفرض وجود ساعتين، واحدة ثابتة، والأخرى تجري بسرعة معينة، بعد مدة سنجد أنهما تختلفان في تسجيل مقدار ما مضى من الوقت(10). ولذلك يمكن لملاحظين اثنين ـ في فضاءين بإحداثيات مختلفة ـ أن تختلف نظرتهما لحدثين، فيراهما الأول متزامنين، بينما يراهما الثاني متعاقبين. والحدث يمكن أن يكون قديمًا جدًا للملاحظ «أ»، ويكون وقع منذ قليل بالنسبة للملاحظ «ب»، بينما «ج» لا يعرفه بعد، فهو يقع في مستقبله. ولهذا كانت الأزمنة الثلاثة نسبية، وأنت حين تبصر نجمة في السماء فإنك لا تراها حقيقة، بل ترى صورتها فقط، وهي التي أرسلتها أشعة النجم منذ ملايين السنين، ووصلتك الآن. أما النجمة ـ حين إبصارك إياها ـ تكون قد انتقلت إلى مكان آخر(11).مثال المسافر:لنتصور مثلاً أخوين توأمين صغيرين يعيشان في مكان واحد، ثم إن أحدهما سافر في مركبة فضائية بسرعة تقرب من سرعة الضوء، بينما اختار الثاني البقاء في الأرض، بعد مدة إذا عاد الأول سيجد أن أخاه قد صار شيخًا، بينما هو لا يزال شابًا كأن سنة واحدة فقط من عمره هي التي مرت. ولو فرضنا كان للأول أبناء يمكن حين العودة أن يكونوا أكبر منه سنًا.هذا مثال يشرح مفهوم الزمن النسبي، وهو من الناحية الفيزيائية لا شك في إمكانه، وأكدته أيضًا تجارب اصطحاب الساعات النووية في الطائرات السريعة(12).ما هو ـ إذًا ـ هذا البعد الرابع؟رغم ما قدمته النسبية لفهم موضوع الزمان، يظل السؤال مستمرًا: ما هو الزمان؟ وحين نقول إنه البعد الرابع مع الأبعاد الثلاثة للفضاء، فإننا نكون كمن يفسر الزمان بالفضاء بالزمان. ثم إنه ـ كما قال «أوسبونسكي» ـ يستحيل علينا أن نتخيل في فضائنا نحن جسمًا له أكثر من ثلاثة أبعاد، كما يستحيل أن نتصور قوانينه الخاصة به(13).برجسون ينقد النسبية:المشكلة في النسبية أنها قررت التعادل الفيزيائي بين الفضاء والزمان، ولكنها لم تفسر الفروق بينهما، وهي فروق واضحة في التجربة وعلى مستوى إحساسنا. كما أنها لا تفسر لماذا لا يرجع الزمان إلى الوراء بخلاف المكان(14).ولهذا كان لبرجسون مثلاً رأي آخر في الزمان: إن الزمان الفيزيائي الذي نحسبه بالوحدات يشوه الزمان الحقيقي الحي، هذا الذي نشعر به في قرارة أنفسنا ونميز فيه بين الأزمنة الثلاثة، على حين كان الزمان الأول مجرد نوع من الحاضر الدائم. والزمان الطبيعي ـ وأساسه المدة dureصe لا اللحظة instant ـ غني بالاحتمالات وواعد بالإبداع والحياة... ولكن العقل العلمي والتقني يعجز عن إدراك حقيقة هذا الزمان الحي، لهذا لا يراهن برجسون على العلم لتحقيق هذا الإدراك(15).مشكلة رجعية الزمان:لماذا لا ينعطف الزمان إلى الوراء، ويظل يتقدم أبدًا؟ نحن نعرف هذه الظاهرة حين ندرك أن الماضي لا يعود، فقد تركناه وراءنا، أما المستقبل فهو دائمًا أمامنا.وهنا مرة أخرى يبرز الفرق بين الزمان الفيزيائي والزمان الحي، أو «الواقعي». ذلك أن الزمان في الفيزياء ـ الكلاسيكية والنسبية ـ ينعطف إلى الوراء، وفي معادلاتها يكون الزمن (وهو العامل t) إيجابًا (+t)، وسلبًا (t) (16-).ولهذا رفض أينشتين مبدأ «عدم رجعية الزمان» وأنه يسري في الكون، وتمسك بما تعطيه الميكانيكا النسبية من إمكان رجعية الزمان: وفي حالة ما إذا تصورنا أن سلسلة الزمان دائرية، يمكن للمستقبل أن يلحق بالماضي. ولذا فإن تقسيمنا الزمان إلى ثلاثة مراحل مجرد وهم(17).ورأى آخرون في بعض مبادئ الديناميكا الحرارية الدليل على وجود «سهم الزمان»، أي أنه لا يتحرك إلا في اتجاه واحد. وذلك أن للكون طاقة معينة، وهي لا تتبدد بل تتحول من نوع إلى آخر. لكن هذا التحول يسير وفق اتجاه محدد، فالطاقة الحركية قد تتحول إلى حرارية، والعكس غير ممكن. وكل نسق مغلق ـ بما في ذلك الكون ـ يفقد حرارته ويسير نحو البرودة. فهذه التطورات التي تحدث كلها في اتجاه واحد غير رجعي، تشير ـ عند البعض ـ إلى «سهم الزمان»(18).الزمان في القرآن والسنة:مما يلفت انتباه دارس الوحي الكريم حضور موضوع الزمان فيه عبر نصوص كثيرة. وتتبع هذا وبحثه يشكل دراسة مستقلة وواسعة لا تحتملها هذه المقالة. فمن ذلك أن القرآن يتحدث عن أزمنة مختلفة لا عن زمان واحد: {وإنَّ يّوًمْا عٌندّ رّبٌَكّ كّأّلًفٌ سّنّةُ مٌَمَّا تّعٍدٍَونّ} سورة الحج 47. ويقرر قدرة النوم على تجاوز الزمن، كما في قصة أهل الكهف الذين قالوا بعد 309 سنوات من الرقاد: {لّبٌثًنّا يّوًمْا أّوً بّعًضّ يّوًمُ} [الكهف:19]. ويمكن لجسم الإنسان أن يتحمل عمرًا طويلاً جدًا، كما حدث لنوح عليه السلام الذي عاش قرونًا.ومن الغريب أيضًا أن وحدة القياس في أخبار الوحي عن الآخرة وأحوالها هي الزمن، ففي الجنة تسير مئات الأعوام ولا تحدها. والخلق يوم يحشرون ينتظرون الحساب أربعين سنة. ومن أودية جهنم ما يهوي فيه الشيء سبعين خريفًا ولا يبلغ قعره.. إلخ(19).والخلود أمر غامض، هل يعني توقف الزمان أو «موته»، أم يعني استمراره وسيلانه في حركة لا تتوقف أبدًا. وفي الحديث النبوي أنه يؤتى يوم القيامة بالموت في صورة خروف فيذبح، ويعلن عن بداية خلود أهل الآخرة. بينما تفيد أحاديث أخرى أن أهل الجنة يعرفون يوم الجمعة ويحفلون به(20).وقد روى البخاري ومسلم أن نبيًا غزا، فدعا الله تعالى أن يحبس عليه الشمس حتى يفتح القرية المحاصرة، وكان الوقت عصرًا(21).فهذا الحديث ـ الذي وردت فكرته أيضًا في العهد القديم ـ يحتمل قراءتين: الأولى أن الزمان في المعركة استمر ولم يتوقف، رغم أن الشمس توقفت عن دورانها (أو نقول توقفت الأرض). وهذا معناه أن الزمان شيء ذاتي يوجد بداخلنا. وهذه قراءة القديس أغسطين(22). والقراءة الثانية، هي أن الزمن توقف بتوقف حركة الأفلاك، ولذلك فالمعركة دارت في غير زمان.خاتمة:إن موضوع الزمان يستعصي على الفهم البشري الذي لا يستطيع أن يضع له خاتمة. فهذا الموضوع يتجاوز العقل، أو لنقل فيه أشياء كثيرة تتجاوز العقل. ولكن هذا لا يمنع من البحث فيه باستمرار على أمل فك بعض ألغازه المعلقة، حيث لا يمكن فكها جميعًا. {سٍبًحّانّكّ لا عٌلًمّ لّنّا إلاَّ مّا عّلَّمًتّنّا إنَّكّ أّّنتّ پًعّلٌيمٍ پًحّكٌٌيمٍ}.
يثير موضوع الزمان إشكالات لا تنتهي، دون حلها خرط القتاد والصعود إلى السماء. فهذا لغز قديم، بل هو من أقدم ألغاز الفكر والفلسفة، ومن أصعبها تناولاً وأعقدها حلاً. ومع ذلك لا شيء أقرب إلى الإنسان من الزمان، فوجوده نفسه ـ وما فيه من أحاسيس وأعمال ـ يقع داخل إطار الزمان. حاول أن تسأل نفسك هذا السؤال وأن تجيب عنه: ما هو الزمان؟
انظر أسفله، أو الرابط: http://www.almarefh.org/news.php?acti...
مجلة المعرفة/ العدد 93 / ما هو الزمان؟
إلياس بلكا :
يثير موضوع الزمان إشكالات لا تنتهي، دون حلها خرط القتاد والصعود إلى السماء. فهذا لغز قديم، بل هو من أقدم ألغاز الفكر والفلسفة، ومن أصعبها تناولاً وأعقدها حلاً. ومع ذلك لا شيء أقرب إلى الإنسان من الزمان، فوجوده نفسه ـ وما فيه من أحاسيس وأعمال ـ يقع داخل إطار الزمان. حاول أن تسأل نفسك هذا السؤال وأن تجيب عنه: ما هو الزمان؟
وقد فرض موضوع الزمان نفسه على العلم المعاصر، خصوصًا بعد ظهور الفيزياء النسبية، فهو اليوم من ألغازه الكبرى التي لم يستطع فك طلاسمها وأسرارها(1).إن الزمان بحر لا ترى له ساحلاً ولا تميز فيه وسطًا من طرف. لقد جعل بعضهم من المستقبل محور الزمن ونقطة ارتكازه، لكن كيف نعتمد على شيء لم يوجد بعد ولا يعرفه أحد. وكذلك الماضي فهو لا يوجد الآن، حيث انقضى وصار في العدم، وقال آخرون فليكن المرجع هو الحاضر، ولكن ما هو الحاضر؟ أليس مجرد معبر عابر بين الماضي والمستقبل، فهو ينفلت منا باستمرار، فليس له امتداد وثبات؟ إن هذا الحاضر قبل أن نفكر فيه يكون ـ في الواقع ـ مستقبلاً، ثم بمجرد أن ننتبه إليه يكون قد صار من الماضي موضوعًا للتأمل والفكر. يقول «وايتهيد»: إن ما نسميه الحاضر هو الجزء الحي من الذاكرة والذي له طابع التوقع(2).ومنذ القدم اختلف الفلاسفة في موضوع الزمان على رأيين:الأول يرى أنه لا وجود للزمان خارج الروح، فهو إحساس ذاتي لا علاقة له بالكون، ولذلك لا نستطيع أن نتمثل الزمان خارج أنفسنا(3). ومن أشهر القائلين بهذا الرأي القديس «أغسطين»(4).والثاني يرى أن الزمان حقيقة واقعية، لها وجودها المستقل، ومن ثم فإن الزمن واحد لا يختلف مهما اختلفت العوالم والحركات والأشخاص. ومن أبرز العلماء الذين ثبتوا هذه الفكرة: نيوتن، وكان يرى أن في الزمان بعدًا أو شيئًا إلهيًا(5).ومهما اعتبرنا الزمان إحساسًا ذاتيًا أو شيئًا واقعيًا، فإن مشكلة أخرى تظهر، وهي: كيف نفسر الزمان؟اعتبر أرسطو أن الزمن هو مقدار الحركة والتحول(6). وهذا التصور هيمن طويلاً على كثير من الاتجاهات الفلسفية، لكنه يثير إشكالات كثيرة بيّن ابن رشد بعضها: فنحن مثلاً نشعر بالزمان حتى حين نكون في الظلمة لا نتحرك. ولو كان الزمان هو حركة الأفلاك السماوية ما أحس به الإنسان الأعمى، أو كان نتيجة حركة معينة أخرى لم يكن للذي لا يراها أي إحساس بالزمان. ثم لو كان الزمن ثمرة أي حركة، غير حركة الأفلاك، لتعددت أنواع الزمان بتعدد أنواع الحركات(7).لكن روح هذا التصور الأرسطي انتقلت إلى بعض العلماء، خصوصًا حين ظهرت النسبية، فالحركة تحدث في مكان، أي في فضاء، وهذه الفيزياء أرست علاقة وطيدة بين الزمان والفضاء.الزمان في الفيزياء النسبية:الزمان هنا لا يوجد مستقلاً ومطلقًا، بل يرتبط بفضاء ما. فإذا تصورنا فضاءين مختلفين كان عندنا زمانان مختلفان. ولما كان الفضاء الأقليدي له أبعاد ثلاثة: الطول والعرض والعمق (إحداثياته x,y,z)؛ فإن الزمان المرتبط به هو بعد رابع (t). والعامل الذي يعادل بين الفضاء والزمن هو العنصر: C.وتوجد مجموعة من المعادلات تربط بين هذه العوامل كلها، منها: x4=ct ومنها: DS2= Dx2+ Dy2+Dz2-c2Dt2والعامل C هو السرعة القصوى، أي سرعة الضوء.ومن نتائج هذا النظر أن الزمن «تحول» إلى الفضاء، بل الفضاء نفسه يمكن أن «يتحول» ـ نسبيًا ـ إلى الزمان. كما أن الزمن يتمطط ويتمدد بالحركة(8).ولهذا اعتبر بعض المفكرين أن هذه الفيزياء تنفي الزمان، مثلها مثل فيزياء نيوتن. فهذا جعل الزمان من المطلق، فهو الحاضر الدائم، والنسبية ربطته بالفضاء ربطًا فيزيائيًا «ماديًا»(9).وأضرب للقارئ هذه الأمثلة لتقريب صورة الزمان في النسبية: لنفرض وجود ساعتين، واحدة ثابتة، والأخرى تجري بسرعة معينة، بعد مدة سنجد أنهما تختلفان في تسجيل مقدار ما مضى من الوقت(10). ولذلك يمكن لملاحظين اثنين ـ في فضاءين بإحداثيات مختلفة ـ أن تختلف نظرتهما لحدثين، فيراهما الأول متزامنين، بينما يراهما الثاني متعاقبين. والحدث يمكن أن يكون قديمًا جدًا للملاحظ «أ»، ويكون وقع منذ قليل بالنسبة للملاحظ «ب»، بينما «ج» لا يعرفه بعد، فهو يقع في مستقبله. ولهذا كانت الأزمنة الثلاثة نسبية، وأنت حين تبصر نجمة في السماء فإنك لا تراها حقيقة، بل ترى صورتها فقط، وهي التي أرسلتها أشعة النجم منذ ملايين السنين، ووصلتك الآن. أما النجمة ـ حين إبصارك إياها ـ تكون قد انتقلت إلى مكان آخر(11).مثال المسافر:لنتصور مثلاً أخوين توأمين صغيرين يعيشان في مكان واحد، ثم إن أحدهما سافر في مركبة فضائية بسرعة تقرب من سرعة الضوء، بينما اختار الثاني البقاء في الأرض، بعد مدة إذا عاد الأول سيجد أن أخاه قد صار شيخًا، بينما هو لا يزال شابًا كأن سنة واحدة فقط من عمره هي التي مرت. ولو فرضنا كان للأول أبناء يمكن حين العودة أن يكونوا أكبر منه سنًا.هذا مثال يشرح مفهوم الزمن النسبي، وهو من الناحية الفيزيائية لا شك في إمكانه، وأكدته أيضًا تجارب اصطحاب الساعات النووية في الطائرات السريعة(12).ما هو ـ إذًا ـ هذا البعد الرابع؟رغم ما قدمته النسبية لفهم موضوع الزمان، يظل السؤال مستمرًا: ما هو الزمان؟ وحين نقول إنه البعد الرابع مع الأبعاد الثلاثة للفضاء، فإننا نكون كمن يفسر الزمان بالفضاء بالزمان. ثم إنه ـ كما قال «أوسبونسكي» ـ يستحيل علينا أن نتخيل في فضائنا نحن جسمًا له أكثر من ثلاثة أبعاد، كما يستحيل أن نتصور قوانينه الخاصة به(13).برجسون ينقد النسبية:المشكلة في النسبية أنها قررت التعادل الفيزيائي بين الفضاء والزمان، ولكنها لم تفسر الفروق بينهما، وهي فروق واضحة في التجربة وعلى مستوى إحساسنا. كما أنها لا تفسر لماذا لا يرجع الزمان إلى الوراء بخلاف المكان(14).ولهذا كان لبرجسون مثلاً رأي آخر في الزمان: إن الزمان الفيزيائي الذي نحسبه بالوحدات يشوه الزمان الحقيقي الحي، هذا الذي نشعر به في قرارة أنفسنا ونميز فيه بين الأزمنة الثلاثة، على حين كان الزمان الأول مجرد نوع من الحاضر الدائم. والزمان الطبيعي ـ وأساسه المدة dureصe لا اللحظة instant ـ غني بالاحتمالات وواعد بالإبداع والحياة... ولكن العقل العلمي والتقني يعجز عن إدراك حقيقة هذا الزمان الحي، لهذا لا يراهن برجسون على العلم لتحقيق هذا الإدراك(15).مشكلة رجعية الزمان:لماذا لا ينعطف الزمان إلى الوراء، ويظل يتقدم أبدًا؟ نحن نعرف هذه الظاهرة حين ندرك أن الماضي لا يعود، فقد تركناه وراءنا، أما المستقبل فهو دائمًا أمامنا.وهنا مرة أخرى يبرز الفرق بين الزمان الفيزيائي والزمان الحي، أو «الواقعي». ذلك أن الزمان في الفيزياء ـ الكلاسيكية والنسبية ـ ينعطف إلى الوراء، وفي معادلاتها يكون الزمن (وهو العامل t) إيجابًا (+t)، وسلبًا (t) (16-).ولهذا رفض أينشتين مبدأ «عدم رجعية الزمان» وأنه يسري في الكون، وتمسك بما تعطيه الميكانيكا النسبية من إمكان رجعية الزمان: وفي حالة ما إذا تصورنا أن سلسلة الزمان دائرية، يمكن للمستقبل أن يلحق بالماضي. ولذا فإن تقسيمنا الزمان إلى ثلاثة مراحل مجرد وهم(17).ورأى آخرون في بعض مبادئ الديناميكا الحرارية الدليل على وجود «سهم الزمان»، أي أنه لا يتحرك إلا في اتجاه واحد. وذلك أن للكون طاقة معينة، وهي لا تتبدد بل تتحول من نوع إلى آخر. لكن هذا التحول يسير وفق اتجاه محدد، فالطاقة الحركية قد تتحول إلى حرارية، والعكس غير ممكن. وكل نسق مغلق ـ بما في ذلك الكون ـ يفقد حرارته ويسير نحو البرودة. فهذه التطورات التي تحدث كلها في اتجاه واحد غير رجعي، تشير ـ عند البعض ـ إلى «سهم الزمان»(18).الزمان في القرآن والسنة:مما يلفت انتباه دارس الوحي الكريم حضور موضوع الزمان فيه عبر نصوص كثيرة. وتتبع هذا وبحثه يشكل دراسة مستقلة وواسعة لا تحتملها هذه المقالة. فمن ذلك أن القرآن يتحدث عن أزمنة مختلفة لا عن زمان واحد: {وإنَّ يّوًمْا عٌندّ رّبٌَكّ كّأّلًفٌ سّنّةُ مٌَمَّا تّعٍدٍَونّ} سورة الحج 47. ويقرر قدرة النوم على تجاوز الزمن، كما في قصة أهل الكهف الذين قالوا بعد 309 سنوات من الرقاد: {لّبٌثًنّا يّوًمْا أّوً بّعًضّ يّوًمُ} [الكهف:19]. ويمكن لجسم الإنسان أن يتحمل عمرًا طويلاً جدًا، كما حدث لنوح عليه السلام الذي عاش قرونًا.ومن الغريب أيضًا أن وحدة القياس في أخبار الوحي عن الآخرة وأحوالها هي الزمن، ففي الجنة تسير مئات الأعوام ولا تحدها. والخلق يوم يحشرون ينتظرون الحساب أربعين سنة. ومن أودية جهنم ما يهوي فيه الشيء سبعين خريفًا ولا يبلغ قعره.. إلخ(19).والخلود أمر غامض، هل يعني توقف الزمان أو «موته»، أم يعني استمراره وسيلانه في حركة لا تتوقف أبدًا. وفي الحديث النبوي أنه يؤتى يوم القيامة بالموت في صورة خروف فيذبح، ويعلن عن بداية خلود أهل الآخرة. بينما تفيد أحاديث أخرى أن أهل الجنة يعرفون يوم الجمعة ويحفلون به(20).وقد روى البخاري ومسلم أن نبيًا غزا، فدعا الله تعالى أن يحبس عليه الشمس حتى يفتح القرية المحاصرة، وكان الوقت عصرًا(21).فهذا الحديث ـ الذي وردت فكرته أيضًا في العهد القديم ـ يحتمل قراءتين: الأولى أن الزمان في المعركة استمر ولم يتوقف، رغم أن الشمس توقفت عن دورانها (أو نقول توقفت الأرض). وهذا معناه أن الزمان شيء ذاتي يوجد بداخلنا. وهذه قراءة القديس أغسطين(22). والقراءة الثانية، هي أن الزمن توقف بتوقف حركة الأفلاك، ولذلك فالمعركة دارت في غير زمان.خاتمة:إن موضوع الزمان يستعصي على الفهم البشري الذي لا يستطيع أن يضع له خاتمة. فهذا الموضوع يتجاوز العقل، أو لنقل فيه أشياء كثيرة تتجاوز العقل. ولكن هذا لا يمنع من البحث فيه باستمرار على أمل فك بعض ألغازه المعلقة، حيث لا يمكن فكها جميعًا. {سٍبًحّانّكّ لا عٌلًمّ لّنّا إلاَّ مّا عّلَّمًتّنّا إنَّكّ أّّنتّ پًعّلٌيمٍ پًحّكٌٌيمٍ}.
Published on November 27, 2013 00:54
November 24, 2013
جماعة من الباحثين: صدور كتاب "آليات الاستدلال في الفكر الإسلاميّ الوسيط".

صدور كتاب "آليات الاستدلال في الفكر الإسلاميّ الوسيط" أصدر مركز الدراسات والبحوث الإنسانيّة والاجتماعيّة بوجدة (سلسة ندوات ومؤتمرات المركز، 4، 2013)،كتابا جماعيّا بعنوان آليات الاستدلال في الفكر الإسلاميّ الوسيط في 583 صفحة تحت إشراف الأستاذين سعيد البوسكلاوي وتوفيق فائزي. وفيما يلي تقديم الكتاب:يضمّ هذا الكتاب أعمال الندوة العلميّة التي نظّمها مركز الدراسات والبحوث الإنسانيّة والاجتماعيّة بتعاون مع جامعة محمّد الأوّل وكلّية الآداب والعلوم الإنسانيّة بوجدة يومي 13-14 أبريل 2010 بقاعة نداء السلام وقاعة الاجتماعات برئاسة الجامعة في موضوع على قدر كبير من الأهمّية العلميّة، ويتعلّق الأمر بآليات الاستدلال في الفكر الإسلاميّ الوسيط. كان هذا اللقاء العلميّ فرصة لتبادل الآراء والتصوّرات بين الباحثين المشاركين الذين سلّطوا الضوء على جوانب مهمّة من هذا الموضوع وعملوا على مقاربة كثير من القضايا المرتبطة بآليات الاستدلال العقليّ كما مارسها المفكّرون المسلمون في العصر الوسيط أو نظّروا لها في مختلف مجالات العلم. وقد تركّز النقاش حول أنماط الاستدلال وطرق التدليل في العلوم النقليّة والعقليّة، وكذا آليات الحوار والخلاف بين المتكلّمين والفلاسفة، وأشكال التنافس والتنافر بين القياس الشرعيّ والقياس الفلسفيّ وغير ذلك.لقد كان المنطلق هو محاولة الإجابة عن السؤال الرئيس التالي: كيف يشتغل 'العقل' في الفكر الإسلاميّ؟ وعن هذا السؤال تولّدت أسئلة عديدة: هل توجد فروق جوهريّة ومطّردة في طرق التعقّل (raisonnement) لدى الفاعلين في الفقه والنحو والكلام والفلسفة والعلم أم أنّ الطرق تتلوّن حسب فترات معيّنة في تطوّر الأفكار؟ وكيف يفصح 'العقل' عن سبل التدليل (argumentation) في صيغ تواصليّة قصد التبليغ والإقناع؟ هل القياس التمثيليّ والقياس الاستنباطيّ، كما مورسا في الثقافة الإسلاميّة، يمتلكان بنيتين ثابتتين لا تتغيّران ولا تمتزجان أم أنّ النمطين يندمجان حسب ظرفيّات معرفيّة محدّدة وبدرجات مختلفة؟بالفعل، فقد عرف الفكر الإسلاميّ تصوّرات كثيرة ومتباينة بل متعارضة أحيانا تجلّت في طعون متبادلة في قوّة التدليل لدى هذه الفئة أو تلك؛ وقدّمت تبريرات مختلفة لتلك الطعون. فبعض المتكلّمين مثلاً (الشيعة منهم بالخصوص) طعنوا في إجرائية القياس التمثيليّ مثلما طعن فيها جلّ الفلاسفة؛ لكن لكلّ فريق تبريرات مغايرة لتبريرات الآخر. والخلاف بين أبي سعيد السيرافي وأبي بشر متّى القُنّائي، على سبيل المثال، لم يكن منحصراً في مدى وثاقة القياس المنطقيّ وجدواه التطبيقيّة، بل ربّما كان يضمر خلافاً أعمق متعلّقاً بالموقف من اللّغة والفلسفة. ومن محاولات التفضيل أن قام الغزالي بردّ قياس التمثيل إلى قياس الشمول والإعلان عن ضرورة الأخذ بمبادئ قياس الشمول؛ في حين قام ابن تيمية بالضدّ تماماً، إذ اعتبر قياس الشمول غير مفيد، بل ودعا إلى تجاهله ورفضه. وهل من الضروريّ الاستغناء عن أحد النمطين من القياس؟ هل كلّ من رفض القياس التمثيليّ استغنى عنه فعلاً في الممارسة؟ وهل كلّ من رفض القياس البرهانيّ فعَل ذلك عن دراية بالثغرات التي قد تكون منبثّة فيه؟ وكيف يشتغل العلماء في الرياضيات والطبيعيات بفروعها المتنوّعة؟تلك بعض القضايا من بين أخرى كثيرة يحاول هذا الكتاب دراستها مع التركيز، من جهة، على مختلف أنواع الاستدلال في الفكر الإسلاميّ مثل الاستدلال الرياضيّ، الاستدلال الكلاميّ، الاستدلال اللغويّ، الاستدلال المنطقيّ وغيره؛ ومن جهة أخرى، فقد حظيت طرق الاستدلال عند الفلاسفة وخاصّة ابن رشد منهم بحصّة الأسد من هذه المداخلات. لذا، ليس غريبا أن لا يكون هذا الكتاب يدافع عن أطروحة واحدة وأن لا ينطلق من تصوّر واحد نظرا ومنهجا في التعامل مع موضوعه، بقدر ما يحفل بآراء متنوّعة وأطروحات كثيرة، لكنّها متكاملة تصبّ جميعها في محاولة الكشف عن الآليات المنطقيّة والإبستمولوجيّة التي تحكم الاستدلال عند المسلمين في قضايا فكرية محدّدة كما في أبنيتهم الفكريّة بشكل عامّ. ويسعى إلى أن يساهم في فهم السبل المتنوّعة التي سلكها المفكّرون في الثقافة الإسلامية ومدى اشتراكهم في البناء المعرفي عبر التاريخ.هكذا، انتظمت عروض المتدخّلين حسب محاور كثيرة ومتنوّعة من رياضيات ومنطق، وكلام، ولغة، وفلسفة. ففي المحور الأوّل استهل القول بنّاصر البُعزّاتي بقول دقيق حول مفهوم التمييز لدى ابن الهيثم، وتناول أحمـد مصلـح دور البرهـان فـي ديناميـّة التفكيـر الرياضـيّ نموذج الجذر التربيعيّ لدى الحسن بن الهيثـم، في حين قدّم ادريس لمرابط (بالفرنسية) أمثلة عن البراهين المستعملة في الرياضيات العربيّة الإسلاميّة؛ وفي محور المنطق، توقّف محمد مرسلي عند نقد المتكلّمين لقانوني الفكر الأرسططاليسيّين" أو "الخرق الكلاميّ لمبدأ الثالث المرفوع ومبدأ عدم التناقض"، أمّا حسان الباهي فقد أبرز بإيجاز طرق التدليل ومراتب التصديق؛ وفي محور الكلام عمد أحمد علمي حمدان إلى مساءلة قياس الغائب على الشاهد: أصنافه والمقصود منها في نقد ابن حزم لبعض مناهج الاستدلال، وفي دراسة مقارنة تناول سعيد البوسكلاوي دليل الأعراض بين يحيى النحويّ والمتكلّمين؛ وفي محور الأصول واللغة قارب يحي رمضان الاستدلال اللغوي عند الأصوليّين مقاربة تداولية، كما كشف عبد الرحيم بودلال عن طبيعة الاستدلال النحويّ؛ وفي محور الفلسفة اعتنت جلّ المداخلات بابن رشد بشكل مباشر أو غير مباشر. عمد توفيق فائزي إلى مقارنة الفلسفة بين النموذج البرهانيّ والنموذج الخطابيّ، في حين تتبّع فؤاد بن أحمد مسار تطوّر نظرية المثال عند ابن رشد، وتوقّف محمد مساعد عند ابن رشد والبيان على جهة الاستظهار، بينما تعرّض امحمد أيت حمّو لموضوع استخدام ابن رشد لقياس الغائب على الشاهد والجدل رغم نقده لهما، ومن جهته رصد محمّد أبلاغ تطوّر آليات الاستدلال في المغرب من ابن رشد إلى ابن البنّا المراكشي، وأخيرا حاول عبد الجبّار أبوبكر الوقوف على دلالة الازدواجية الآليّة في الثلاثيّة الرشديّة.ولا يسعنا، في الأخير، إلا أن نشكر الأساتذة الباحثين الذين ساهموا في هذا الكتاب، كما نشكر مركز الدراسات والبحوث الإنسانيّة والاجتماعيّة، منار المعرفة في المنطقة الشرقيّة، بجميع أطره النشيطة التي كانت لنا العون الحميد في إنجاح الندوة وإخراج هذا العمل إلى الوجود، والشكر موصول أيضا لرئاسة جامعة محمّد الأوّل وعمادة كلّية الآداب والعلوم الإنسانيّة واللجنة التنظيميّة وكلّ من ساهم في طبع هذا الكتاب الذي نتمنّى له حياة علميّة مفيدة.سعيد البوسكلاويكلّية الآداب، وجدة
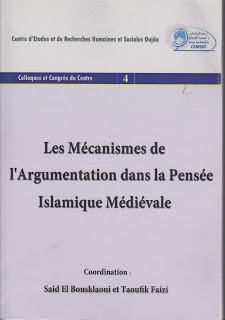
Published on November 24, 2013 03:00
November 23, 2013
سلسلة آفاق جديدة في البحوث الإسلامية (10). البشرية الخائفة:
سلسلة آفاق جديدة في البحوث الإسلامية (10).
البشرية الخائفة :
إلياس بلكا الإنسان الخائف:
لجون دلومو كتاب عن تاريخ الخوف بالغرب. وقد كتب مقالا بعنوان "مخاوف اليوم" في عدد سابق لمجلة "علوم إنسانية"، وهي مجلة شهرية ثقافية عامة مشهورة في الوسط الثقافي الفرنسي والفرنكفوني، والتي خصصت أحد أعدادها لملف عنوانه:" الخوف: من القلق الفردي إلى الهلوسات الجماعية".
وخلاصة المقال أنه ربما كنا اليوم أكثر تعرضا للهلع وسلطته من أجدادنا، أي أشد هشاشة وخوفا. وفعلا يأتي اليوم الرُّهاب –الفوبيا- على رأس الاضطرابات العقلية الأكثر انتشارا مع الإدمان على الكحول والاكتئاب. وتؤكد علوم الأعصاب أنه إذا كانت بعض المخاوف غريزية، فإنه يمكن تعويد الإنسان على مخاوف جديدة. ولذلك يطرح علماء الاجتماع لغز استمرار الخوف في المجتمعات المتقدمة رغم محدودية الأخطار الواقعية، وهذا ما يشير إليه مثلا التطور الكبير لاقتصاديات التأمين.. ويبقى المصدر الأهم للتخوف المعاصر –بحسب المؤرخ جورج دوبي مؤلف كتاب "من عام 1000 ميلادي إلى 2000: في البحث عن آثار مخاوفنا"- هو العلم.. كما يأمل الإنسان اليوم في تجاوز مخاوفه بفضل.. العلم أيضا!! وهذه هي المفارقة الكبيرة.
ويقول كريستوف أندري –وهو طبيب نفساني ومؤلف عدد من الكتب في الموضوع-: إن الدراسات تؤكد اليوم على أن كل واحد من اثنين –في الناس- يعاني من بعض الرهاب والهلع المبالغ فيه، بينما تسجل عند كل شخص من عشرة حالة فوبيا مرضية. وللطب النفسي رؤية للموضوع، إذ طوّر بعض المعالجات، كالمعالجة الذهنية السلوكية، والمعالجة العصبية (إذ توجد بحوث عن آليات الخوف في الدماغ)، والعلاج بالنموذج "البيئي/النفسي/الاجتماعي"...
صناعة الخوف:
وممن اهتموا بهذا الموضوع عالم الاجتماع الأمريكي باري كلاسنر، صاحب الكتاب الناجح "ثقافة الخوف" (نشر سنة 2000)، والذي أثبت فيه أن تجار الخوف يحرصون على إبقاء الأمريكيين تحت سلطة مخاوف كثيرة مضخمة أو غير حقيقية.. فهذا الكتاب يتكامل مع بعض أعمال نعوم تشومسكي التي تسير في الاتجاه نفسه.
ويعتبر كلاسنر أن حياة الأمريكيين لم تكن أكثر أماناً مما هي عليه الآن، رغم التهويل الإعلامي لبعض الأخطار، بل رغم أحداث 11 شتنبر. فإذا كان حوالي ثلاثة آلاف أمريكي قضوا في هذا الهجوم فإن السنة نفسها شهدت مقتل 43 ألف أمريكي في حوادث الطرقات. ويضرب كلاسنر مثالا آخر، ففي أواخر التسعينيات ساد قلق كبير من العنف الذي تشهده أماكن العمل، بينما تقول الإحصائيات إن احتمال مقتل الأمريكي في مقر العمل هو بنسبة واحد على مليونين. إن المستفيد من هذا التغليط هم من يسميهم كلاسنر بتجار الخوف: السياسيون الذين يقترحون في الانتخابات مخاوف لا برامج، والإعلاميون، واللوبيات، وشركات الأمن... ولهؤلاء استراتيجيتان: الأولى– تقديم حوادث معزولة وكأنها ظواهر عامة، والثانية- وهي أخطر، تقديم خبراء مزيفين إلى الجمهور، والزعم بأنهم يتكلمون بمنطق العلم.
وعادة ما تكون مواضيع صناعة الخوف: خصائص بعض الجماعات العرقية، أو أشخاص فرادى، أو ظواهر طبيعية... وقد تتغير هذه المواضيع، لكن التجارة ثابتة، كما يحدث الآن في وهْم الخطر الإسلامي. ودور وسائل الإعلام هنا معقد، فهي جميعا تشارك في هذه التجارة، لكن بعضها يجتهد في تجنّبها. وفي أمريكا تعتبر التلفزة المحلية أو الجهوية العنصر الرائد في هذه التجارة.
لكن هل توجد بالولايات المتحدة أسباب معقولة وحقيقية للفزع، يرى كلاسنر أن العلل الحقيقية للخوف هي العشرة ملايين أمريكي بدون تغطية صحية، والملايين الذين يعانون من سوء التغذية، وآلاف المدارس غير المناسبة، وعدم احترام الحقوق والحريات بدعوى محاربة الإرهاب.. بينما واقع الحال أننا ننفق عشرات الملايير على أخطار وهمية مصطنعة.
"الخوف المعاصر" والمطلوب منـّا:
يوجد سبب رئيس في تنامي المخاوف في عصرنا هذا، وقد اتضحت لي أهميته القصوى من خلال دراسة أكاديمية أنجزتها منذ أكثر من عقد من الزمان حول موضوع "الإسلام والمستقبل".
هذا السبب هو قلق المستقبل، فالناس تخاف ليس فقط نتيجة مشكلات الحاضر، بل أيضا –وربما بالدرجة الأولى- بسبب غموض المستقبل. إذ يوجد اليوم في البشرية شعور عام وراسخ بأن العالم لا يسير في الطريق الصحيح، وأن الحياة لا تتطور وفق السبل السليمة. ولذلك يؤمن الكثيرون بأن انهيارا شاملا لأنماط الحياة المعاصرة سيحدث لا محالة، فقط لا يُعرف متى يكون ذلك.
وحق لهؤلاء أن يخافوا مما تخفيه لهم الأيام، فهذه الأعاصير المدمرة، وهذه السخونة المتصاعدة لطقس الأرض، وهذا النضوب المتسارع لمصادر الطاقة، وهذه الأمراض الغريبة المستعصية على الفهم بله العلاج (الإيدز، والسارس، وجنون البقر...)، وهذا الفقر المنتشر، وهذا التدمير العنيد للبيئة ولثروات الطبيعة وحياتها النباتية والحيوانية، وهذا التسلح المجنون، وهؤلاء السياسيين الكذبة والعسكريين الحمقى... كل هذا أكثر من كاف للخوف والقلق، إن لم يكن على مصيرنا فعلى مصائر أبنائنا.
وهذا لا يناقض ما سماه كلاسنر –عن حق- بتجارة الخوف، بل هذه هي المخاوف المشروعة و المعقولة.. ولكن تجار الخوف يقترحون غيرها ويوهمون بها الناس خدمة لمصالحهم الضيقة.
الواجب علينا –نحن معشر الباحثين والطلاب وعامة المهتمين- أن ندرس ظاهرة الخوف المعاصر، وأن نتفهم أسبابها العميقة ونحصر آثارها الواسعة.. سيكون هذا تمهيدا ضروريا للجواب عن سؤال مركزي: ماذا بإمكان الأديان عموما، والإسلام خصوصا، أن تقدمه لهذه البشرية الفزعة والمفزوعة.. كيف السبيل بتوعيتها بالمخاوف المصطنعة التي يسعى تجار الخوف إلى فرضها عليها.. وكيف نساعدها على تجاوز المخاوف المشروعة والحقيقية.. وقبل ذلك: كيف نجعل البشرية تطمئن للإسلام، فلا تخافه، كيف نحاصر ظاهرة الإسلاموفوبيا.. وهنا لا تكفي الإجابات النظرية، بل لابد معها من اقتراحات عملية..؟؟
البشرية الخائفة :
إلياس بلكا الإنسان الخائف:
لجون دلومو كتاب عن تاريخ الخوف بالغرب. وقد كتب مقالا بعنوان "مخاوف اليوم" في عدد سابق لمجلة "علوم إنسانية"، وهي مجلة شهرية ثقافية عامة مشهورة في الوسط الثقافي الفرنسي والفرنكفوني، والتي خصصت أحد أعدادها لملف عنوانه:" الخوف: من القلق الفردي إلى الهلوسات الجماعية".
وخلاصة المقال أنه ربما كنا اليوم أكثر تعرضا للهلع وسلطته من أجدادنا، أي أشد هشاشة وخوفا. وفعلا يأتي اليوم الرُّهاب –الفوبيا- على رأس الاضطرابات العقلية الأكثر انتشارا مع الإدمان على الكحول والاكتئاب. وتؤكد علوم الأعصاب أنه إذا كانت بعض المخاوف غريزية، فإنه يمكن تعويد الإنسان على مخاوف جديدة. ولذلك يطرح علماء الاجتماع لغز استمرار الخوف في المجتمعات المتقدمة رغم محدودية الأخطار الواقعية، وهذا ما يشير إليه مثلا التطور الكبير لاقتصاديات التأمين.. ويبقى المصدر الأهم للتخوف المعاصر –بحسب المؤرخ جورج دوبي مؤلف كتاب "من عام 1000 ميلادي إلى 2000: في البحث عن آثار مخاوفنا"- هو العلم.. كما يأمل الإنسان اليوم في تجاوز مخاوفه بفضل.. العلم أيضا!! وهذه هي المفارقة الكبيرة.
ويقول كريستوف أندري –وهو طبيب نفساني ومؤلف عدد من الكتب في الموضوع-: إن الدراسات تؤكد اليوم على أن كل واحد من اثنين –في الناس- يعاني من بعض الرهاب والهلع المبالغ فيه، بينما تسجل عند كل شخص من عشرة حالة فوبيا مرضية. وللطب النفسي رؤية للموضوع، إذ طوّر بعض المعالجات، كالمعالجة الذهنية السلوكية، والمعالجة العصبية (إذ توجد بحوث عن آليات الخوف في الدماغ)، والعلاج بالنموذج "البيئي/النفسي/الاجتماعي"...
صناعة الخوف:
وممن اهتموا بهذا الموضوع عالم الاجتماع الأمريكي باري كلاسنر، صاحب الكتاب الناجح "ثقافة الخوف" (نشر سنة 2000)، والذي أثبت فيه أن تجار الخوف يحرصون على إبقاء الأمريكيين تحت سلطة مخاوف كثيرة مضخمة أو غير حقيقية.. فهذا الكتاب يتكامل مع بعض أعمال نعوم تشومسكي التي تسير في الاتجاه نفسه.
ويعتبر كلاسنر أن حياة الأمريكيين لم تكن أكثر أماناً مما هي عليه الآن، رغم التهويل الإعلامي لبعض الأخطار، بل رغم أحداث 11 شتنبر. فإذا كان حوالي ثلاثة آلاف أمريكي قضوا في هذا الهجوم فإن السنة نفسها شهدت مقتل 43 ألف أمريكي في حوادث الطرقات. ويضرب كلاسنر مثالا آخر، ففي أواخر التسعينيات ساد قلق كبير من العنف الذي تشهده أماكن العمل، بينما تقول الإحصائيات إن احتمال مقتل الأمريكي في مقر العمل هو بنسبة واحد على مليونين. إن المستفيد من هذا التغليط هم من يسميهم كلاسنر بتجار الخوف: السياسيون الذين يقترحون في الانتخابات مخاوف لا برامج، والإعلاميون، واللوبيات، وشركات الأمن... ولهؤلاء استراتيجيتان: الأولى– تقديم حوادث معزولة وكأنها ظواهر عامة، والثانية- وهي أخطر، تقديم خبراء مزيفين إلى الجمهور، والزعم بأنهم يتكلمون بمنطق العلم.
وعادة ما تكون مواضيع صناعة الخوف: خصائص بعض الجماعات العرقية، أو أشخاص فرادى، أو ظواهر طبيعية... وقد تتغير هذه المواضيع، لكن التجارة ثابتة، كما يحدث الآن في وهْم الخطر الإسلامي. ودور وسائل الإعلام هنا معقد، فهي جميعا تشارك في هذه التجارة، لكن بعضها يجتهد في تجنّبها. وفي أمريكا تعتبر التلفزة المحلية أو الجهوية العنصر الرائد في هذه التجارة.
لكن هل توجد بالولايات المتحدة أسباب معقولة وحقيقية للفزع، يرى كلاسنر أن العلل الحقيقية للخوف هي العشرة ملايين أمريكي بدون تغطية صحية، والملايين الذين يعانون من سوء التغذية، وآلاف المدارس غير المناسبة، وعدم احترام الحقوق والحريات بدعوى محاربة الإرهاب.. بينما واقع الحال أننا ننفق عشرات الملايير على أخطار وهمية مصطنعة.
"الخوف المعاصر" والمطلوب منـّا:
يوجد سبب رئيس في تنامي المخاوف في عصرنا هذا، وقد اتضحت لي أهميته القصوى من خلال دراسة أكاديمية أنجزتها منذ أكثر من عقد من الزمان حول موضوع "الإسلام والمستقبل".
هذا السبب هو قلق المستقبل، فالناس تخاف ليس فقط نتيجة مشكلات الحاضر، بل أيضا –وربما بالدرجة الأولى- بسبب غموض المستقبل. إذ يوجد اليوم في البشرية شعور عام وراسخ بأن العالم لا يسير في الطريق الصحيح، وأن الحياة لا تتطور وفق السبل السليمة. ولذلك يؤمن الكثيرون بأن انهيارا شاملا لأنماط الحياة المعاصرة سيحدث لا محالة، فقط لا يُعرف متى يكون ذلك.
وحق لهؤلاء أن يخافوا مما تخفيه لهم الأيام، فهذه الأعاصير المدمرة، وهذه السخونة المتصاعدة لطقس الأرض، وهذا النضوب المتسارع لمصادر الطاقة، وهذه الأمراض الغريبة المستعصية على الفهم بله العلاج (الإيدز، والسارس، وجنون البقر...)، وهذا الفقر المنتشر، وهذا التدمير العنيد للبيئة ولثروات الطبيعة وحياتها النباتية والحيوانية، وهذا التسلح المجنون، وهؤلاء السياسيين الكذبة والعسكريين الحمقى... كل هذا أكثر من كاف للخوف والقلق، إن لم يكن على مصيرنا فعلى مصائر أبنائنا.
وهذا لا يناقض ما سماه كلاسنر –عن حق- بتجارة الخوف، بل هذه هي المخاوف المشروعة و المعقولة.. ولكن تجار الخوف يقترحون غيرها ويوهمون بها الناس خدمة لمصالحهم الضيقة.
الواجب علينا –نحن معشر الباحثين والطلاب وعامة المهتمين- أن ندرس ظاهرة الخوف المعاصر، وأن نتفهم أسبابها العميقة ونحصر آثارها الواسعة.. سيكون هذا تمهيدا ضروريا للجواب عن سؤال مركزي: ماذا بإمكان الأديان عموما، والإسلام خصوصا، أن تقدمه لهذه البشرية الفزعة والمفزوعة.. كيف السبيل بتوعيتها بالمخاوف المصطنعة التي يسعى تجار الخوف إلى فرضها عليها.. وكيف نساعدها على تجاوز المخاوف المشروعة والحقيقية.. وقبل ذلك: كيف نجعل البشرية تطمئن للإسلام، فلا تخافه، كيف نحاصر ظاهرة الإسلاموفوبيا.. وهنا لا تكفي الإجابات النظرية، بل لابد معها من اقتراحات عملية..؟؟
Published on November 23, 2013 01:00
November 17, 2013
المهدوية عقيدة مستقبلية خطرة
نشرت مجلة الرشاد الفكرية اتي تصدر من الولايات المتحدة الأمريكية مقالي هذا في وقت سابق، وذلك بالعدد 16:
(من أفكار البحث أن المشكلة ليست في أحاديث المهدي، فهي صحيحة وثابتة، بل في سوء فهمها وفي سوء تنزيلها على الواقع التاريخي الإسلامي.)
انظر المقال كاملا أدناه، أو على الرابط: http://www.alrashad.org/issues/16/16-...
المهدوية عقيدة مستقبلية خطرةد. إلياس بلكاو من ثم رد بعض العلماء أحاديث تعارض الرؤية القرآنية أو القواعد الكلية التي استقرأها العلماء من جملة التوجيهات القرآنية و السنة النبوية . و إن من الأيسر أن ننسب الوهم أو الغلط إلى غير المعصوم من أن نعبث بالمعاني المستقرة للتكليف أو السنن المستقرة في الكون و التي أطلق عليها العلماء طبائع العمران أو مجاري العادات. فان ثبتت صحة حديث ما رجعنا إلى العلماء المحققين ليفسروا الاجمال ويرفعوا التعارض، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.لكن المشكلة ليست في أحاديث المهدي، فهي صحيحة وثابتة، بل المشكلة في سوء فهمها وفي سوء تنزيلها على الواقع التاريخي الإسلامي.وقد كان موقف ابن خلدون من هذه الحيثية أقوى وأولى… فهو لم يقل إن أخبار المهدي موضوعة اعتماداً منه على ما لاحظه من آثارها السلبية في التاريخ الإسلامي . بل أضاف إلى فهمه الكلي لحركة التاريخ تحليلاً دقيقاً للروايات فدرسها وبين ضعفها من وجوه مختلفة كغفلة الراوي أو سوء حفظه أو تشيع قوي فيه أو اختلاف في رفعه أو وقفه . فجمع ابن خلدون بين االمنهجين الدراية والرواية .و مما يدعم اجتهاد ابن خلدون في موضوع المهدي أن العلماء – حتى من صحح أخبار المهدي منهم - اعتبروا أن الاعتقاد في المهدي أمر ثانوي ليس له كبير شأن ضمن العقائد الإسلامية ، فليس هو من عقائد الدين ولا مما يجب أن يعلم من الدين بالضرورة ، ولا أهمية له بالنسبة إلى حاضر الإسلام ولا إلى مستقبله. فليس المهدي نبياً ، ولن يأتي بوحي جديد ، ولن يغير من شريعة الإسلام شيئاً ، فلا يزيد فيها ولا ينقص … إنما هو رجل متبع للكتاب والسنة اللذين هما بين أيدينا الآن. فالمهدي – لمن أراد أن يعتبر بعض الأخبار الواردة بشأنه - أشبه بزعيم أو مصلح ديني عادي ولو أردنا مثالاً عن المهدي في تاريخ الإسلام لكان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه و عن جميع العلماء و الأئمة المجاهدين. وعليه فإن انتظار المهدي وبناء الآمال العظام على بروزه ، وصرف الأزمان في الكسل والسلبية بدعوى انتظاره .. كل هذا بدعة في الدين وتحريف لروحه وشيء لا يجوز . لقد جاء في رواية أبي داود وابن حبان أن المهدي يمكث في المسلمين سبع سنين . ألحكم رجل سبع سنوات تتوقف حياة الأمة ويعلق مصيرها وتركد حركتها ويتوقف جهادها .. سبعين قرناً ؟و من ناحية أخرى نرى أنه من المفيد التعرف على اهتمام الشيعة بهذا الموضوع ويظهر من كلام النوبختي – أحد رؤوس الإمامية في زمانه – أن عبد الله بن سبأ وأتباعه أول من قالوا – حين قتل علي – إنه لم يمت ، ولن يموت حتى يحكم العرب ويملأ الأرض عدلا... كاتب وباحث متخصص في أصول الفقه والعقيدة والفكر راجع "باب في الخليفة الكائن في آخر الزمان المسمى بالمهدي وعلامة خروجه"، في كتاب التذكرة لمحمد القرطبي، 2/287 إلى 306. الحاوي للفتاوى، 2/7. وهي مطبوعة ضمن: الحاوي للفتاوى 2/123 إلى 166. راجع المقدمة ص 242 إلى 245. ومن الذين ضعفوا أحاديث المهدي: الدارقطني والذهبي، بحسب ما في رسالة عبد الله آل محمود: "لا مهدي ينتظر" المطبوعة ضمن مجموع رسائله 3/584. [5] التحرير والتنوير ، المطبوعة ضمن مجموعة رسائله 1/628 (البقرة 100). صرح الكاتب بأن هذه الأحاديث موضوعة في مواضع من رسالته ، منها : ص 544 ، وص 547 ، راجع الرسالة ضمن "مجموعة رسائل عبد الله آل محمود"، 3/543 إلى 614. والشيخ هو رئيس الإدارات الشرعية بقطر، له كتب ومقالات مختلفة، منها دراسة فقهية عن التأمين. وهو من أهل البيت كما ذكر في رسالته. هو أبو الفيض أحمد بن الصديق ، محدث حافظ من طنجه بالمغرب ، ثم هاجر إلى مصر وعاش بها ، توفي سنة 1960 ، كما هو معجم المؤلفين 13/368. ولهذا المخطوط عنوان آخر هو: "إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون " . راجع : المرشد المهدي ، ص 3 إلى 12 . مخطوط : المرشد المهدي لرد طعن ابن خلدون في أحاديث المهدي ، ص 14 إلى 131، وقارن ذلك بفصل : التحقيق المعتبر عن أحاديث المهدي المنتظر ، في رسالة عبد الله آل محمود : " لامهدي ينتظر " 3/568 فما بعدها . انظر : المرشد المهدي …ص 139 إلى 161 . المرشد المهدي ، ص 163 ، انظر حول هذا الحديث أيضاً : العرف الوردي ، ص 165 ، وقد أورد القرطبي حديثاً طويلاً في خروج المهدي من الغرب الأقصى ، قال فيه السيوطي : لا أصل لذلك ، انظر : العرف الوردي في أخبار المهدي ، ص 166 ، التذكرة 2/300 . فرق الشيعة ، ص 32-33 . راجع على سبيل المثال : فرق الشيعة ، للنوبختي ، صفحات : 35-36 ، 41 ، 45 ، 47 ، 75 .. انظر "الزيدية" لأحمد محمود صبحي ، ص 101 ، 104 . آخر أئمة الزيدية ، من أسرة حميد الدين ، هو محمد البدر المنصور بالله، وقد أزيح عن الحكم يوم 26 شتبر 1962 حين قامت الثورة وأعلنت الجمهورية بدعم من مصر ، انظر : الزيدية ، ص 598 . انظر : فرق الشيعة ، للنوبختي ، عند كلامه عن الإمامية ، ص 105 إلى 108 . الفرق بين الفرق ، ص 268 . نقله محمد جواد مغنية في كتابه : " الخميني والدولة الإسلامية " ص 61 . راجع كتاب محمد جواد مغنية - وهو من الشيعة الإمامية الذين لا يرون ولاية الفقيه - " الخميني والدولة الإسلامية ، خصوصاً صفحة 59 إلى 75 ، ففيه نصوص عن بعض علماء الإمامية الذين رفضوا فكرة الولاية العامة. ومحمد مغنية أصله من لبنان وله عدد من المؤلفات في التفسير وأصول الفقه .. راجع الصحف الوطنية والدولية لايام 27 نوفمبر 1997 فما بعدها . منها : صحيفة الاتحاد الاشتراكي، 28 نوفمبر 1997 و 14 دجنبر 1997
(من أفكار البحث أن المشكلة ليست في أحاديث المهدي، فهي صحيحة وثابتة، بل في سوء فهمها وفي سوء تنزيلها على الواقع التاريخي الإسلامي.)
انظر المقال كاملا أدناه، أو على الرابط: http://www.alrashad.org/issues/16/16-...
المهدوية عقيدة مستقبلية خطرةد. إلياس بلكاو من ثم رد بعض العلماء أحاديث تعارض الرؤية القرآنية أو القواعد الكلية التي استقرأها العلماء من جملة التوجيهات القرآنية و السنة النبوية . و إن من الأيسر أن ننسب الوهم أو الغلط إلى غير المعصوم من أن نعبث بالمعاني المستقرة للتكليف أو السنن المستقرة في الكون و التي أطلق عليها العلماء طبائع العمران أو مجاري العادات. فان ثبتت صحة حديث ما رجعنا إلى العلماء المحققين ليفسروا الاجمال ويرفعوا التعارض، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.لكن المشكلة ليست في أحاديث المهدي، فهي صحيحة وثابتة، بل المشكلة في سوء فهمها وفي سوء تنزيلها على الواقع التاريخي الإسلامي.وقد كان موقف ابن خلدون من هذه الحيثية أقوى وأولى… فهو لم يقل إن أخبار المهدي موضوعة اعتماداً منه على ما لاحظه من آثارها السلبية في التاريخ الإسلامي . بل أضاف إلى فهمه الكلي لحركة التاريخ تحليلاً دقيقاً للروايات فدرسها وبين ضعفها من وجوه مختلفة كغفلة الراوي أو سوء حفظه أو تشيع قوي فيه أو اختلاف في رفعه أو وقفه . فجمع ابن خلدون بين االمنهجين الدراية والرواية .و مما يدعم اجتهاد ابن خلدون في موضوع المهدي أن العلماء – حتى من صحح أخبار المهدي منهم - اعتبروا أن الاعتقاد في المهدي أمر ثانوي ليس له كبير شأن ضمن العقائد الإسلامية ، فليس هو من عقائد الدين ولا مما يجب أن يعلم من الدين بالضرورة ، ولا أهمية له بالنسبة إلى حاضر الإسلام ولا إلى مستقبله. فليس المهدي نبياً ، ولن يأتي بوحي جديد ، ولن يغير من شريعة الإسلام شيئاً ، فلا يزيد فيها ولا ينقص … إنما هو رجل متبع للكتاب والسنة اللذين هما بين أيدينا الآن. فالمهدي – لمن أراد أن يعتبر بعض الأخبار الواردة بشأنه - أشبه بزعيم أو مصلح ديني عادي ولو أردنا مثالاً عن المهدي في تاريخ الإسلام لكان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه و عن جميع العلماء و الأئمة المجاهدين. وعليه فإن انتظار المهدي وبناء الآمال العظام على بروزه ، وصرف الأزمان في الكسل والسلبية بدعوى انتظاره .. كل هذا بدعة في الدين وتحريف لروحه وشيء لا يجوز . لقد جاء في رواية أبي داود وابن حبان أن المهدي يمكث في المسلمين سبع سنين . ألحكم رجل سبع سنوات تتوقف حياة الأمة ويعلق مصيرها وتركد حركتها ويتوقف جهادها .. سبعين قرناً ؟و من ناحية أخرى نرى أنه من المفيد التعرف على اهتمام الشيعة بهذا الموضوع ويظهر من كلام النوبختي – أحد رؤوس الإمامية في زمانه – أن عبد الله بن سبأ وأتباعه أول من قالوا – حين قتل علي – إنه لم يمت ، ولن يموت حتى يحكم العرب ويملأ الأرض عدلا... كاتب وباحث متخصص في أصول الفقه والعقيدة والفكر راجع "باب في الخليفة الكائن في آخر الزمان المسمى بالمهدي وعلامة خروجه"، في كتاب التذكرة لمحمد القرطبي، 2/287 إلى 306. الحاوي للفتاوى، 2/7. وهي مطبوعة ضمن: الحاوي للفتاوى 2/123 إلى 166. راجع المقدمة ص 242 إلى 245. ومن الذين ضعفوا أحاديث المهدي: الدارقطني والذهبي، بحسب ما في رسالة عبد الله آل محمود: "لا مهدي ينتظر" المطبوعة ضمن مجموع رسائله 3/584. [5] التحرير والتنوير ، المطبوعة ضمن مجموعة رسائله 1/628 (البقرة 100). صرح الكاتب بأن هذه الأحاديث موضوعة في مواضع من رسالته ، منها : ص 544 ، وص 547 ، راجع الرسالة ضمن "مجموعة رسائل عبد الله آل محمود"، 3/543 إلى 614. والشيخ هو رئيس الإدارات الشرعية بقطر، له كتب ومقالات مختلفة، منها دراسة فقهية عن التأمين. وهو من أهل البيت كما ذكر في رسالته. هو أبو الفيض أحمد بن الصديق ، محدث حافظ من طنجه بالمغرب ، ثم هاجر إلى مصر وعاش بها ، توفي سنة 1960 ، كما هو معجم المؤلفين 13/368. ولهذا المخطوط عنوان آخر هو: "إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون " . راجع : المرشد المهدي ، ص 3 إلى 12 . مخطوط : المرشد المهدي لرد طعن ابن خلدون في أحاديث المهدي ، ص 14 إلى 131، وقارن ذلك بفصل : التحقيق المعتبر عن أحاديث المهدي المنتظر ، في رسالة عبد الله آل محمود : " لامهدي ينتظر " 3/568 فما بعدها . انظر : المرشد المهدي …ص 139 إلى 161 . المرشد المهدي ، ص 163 ، انظر حول هذا الحديث أيضاً : العرف الوردي ، ص 165 ، وقد أورد القرطبي حديثاً طويلاً في خروج المهدي من الغرب الأقصى ، قال فيه السيوطي : لا أصل لذلك ، انظر : العرف الوردي في أخبار المهدي ، ص 166 ، التذكرة 2/300 . فرق الشيعة ، ص 32-33 . راجع على سبيل المثال : فرق الشيعة ، للنوبختي ، صفحات : 35-36 ، 41 ، 45 ، 47 ، 75 .. انظر "الزيدية" لأحمد محمود صبحي ، ص 101 ، 104 . آخر أئمة الزيدية ، من أسرة حميد الدين ، هو محمد البدر المنصور بالله، وقد أزيح عن الحكم يوم 26 شتبر 1962 حين قامت الثورة وأعلنت الجمهورية بدعم من مصر ، انظر : الزيدية ، ص 598 . انظر : فرق الشيعة ، للنوبختي ، عند كلامه عن الإمامية ، ص 105 إلى 108 . الفرق بين الفرق ، ص 268 . نقله محمد جواد مغنية في كتابه : " الخميني والدولة الإسلامية " ص 61 . راجع كتاب محمد جواد مغنية - وهو من الشيعة الإمامية الذين لا يرون ولاية الفقيه - " الخميني والدولة الإسلامية ، خصوصاً صفحة 59 إلى 75 ، ففيه نصوص عن بعض علماء الإمامية الذين رفضوا فكرة الولاية العامة. ومحمد مغنية أصله من لبنان وله عدد من المؤلفات في التفسير وأصول الفقه .. راجع الصحف الوطنية والدولية لايام 27 نوفمبر 1997 فما بعدها . منها : صحيفة الاتحاد الاشتراكي، 28 نوفمبر 1997 و 14 دجنبر 1997
Published on November 17, 2013 23:44
سلسلة آفاق جديدة في البحوث الإسلامية (8). جيوبولتيك المسيـحية.
سلسلة آفاق جديدة في البحوث الإسلامية (8).
جيوبولتيك المسيحية:
إلياس بلكا
هذه خلاصات وتأملات على هامش قراءاتي لعدد سابق لمجلة "الدبلوماسية"، وهي فصلية تصدر باللغة الفرنسية، ومحور العدد مقالات حاولت الإجابة عن سؤال كبير، وهو: "هل للمسيحية اليوم استراتيجية عالمية ؟" عودة الأديان:
يؤكد صاحب مقال "المظاهر الجيوبولتيكية للمسيحية" على دور الدين في عصرنا، وأنه عامل سياسي واستراتيجي مهم جدا. وتعني جيوبولتيك علاقة السياسة بالجغرافيا، لذا نترجم الكلمة أحيانا بـ: الجغرافيا السياسية.
وفي هذا السياق كتب ألبريك لاكومب –باحث بمركز التحليل وتوقع المخاطر الدولية- خلاصة لإحدى الدراسات المستقبلية حول أوضاع الأديان في أفق سنة 2020، معززا ذلك بخريطة جغرافية استشرافية. وهذه أهم نتائج الدراسة: تقدم البروتستانتية في أمريكا الوسطى والجنوبية على حساب الكاثوليكية. وتقدم التبشير البروتستانتي والإنجيلي بإفريقيا الاستوائية والجنوبية. وتقدم الإسلام بآسيا الوسطى. ونمو الشعور الديني بروسيا والصين.
والملاحظة الأهم هنا هي أن مستقبل الدين –وفق هذه الدراسة- جيد، وأن صحوة عامة لمختلف الأديان قادمة. والمنطقة الوحيدة في العالم التي ستعرف تقدم اللادينية هي أوربا الغربية. وأقول: في 2020 أيضا –وما بعدها- سيكون وزن هذه المنطقة بالنسبة للعالم أقل وأضعف سكانيا واقتصاديا وسياسيا.
مشكلات الكنيسة الكاثوليكية:
يرى جون برنارد رايمون –وزير فرنسا السابق للشؤون الخارجية وسفيرها بالفاتيكان سابقا- أن من أهم التحديات التي على الكنيسة مواجهتها اليوم، خاصة الكاثوليكية: زواج القسس، والقضايا البيولوجية التي تثير أسئلة أخلاقية، والتقريب بين الكنائس المسيحية، وحوار الأديان (والمقصود هنا أساسا: الإسلام)، ومسألة الأرثذوكسية الروسية.
ويضيف تحديات أخرى، كمشكلة تراجع المسيحية والتديّن بها في بعض المناطق، وتحول الثقل العددي للمسيحية من الشمال إلى الجنوب، والتأثير المتصاعد للإنجيليين خصوصا بإفريقيا، والعلاقة مع الصين.
وتعرض مقال آخر لمنظمة أوبوس داي (أي عمل الله) التي ينتمي إليها أكثر من 85 ألف واحد في القارات الخمس، لا يشكل رجال الدين من بينهم أكثر من 2%. وهدف هذه المنظمة شبه السرية هو تمسيح الحياة العامة ناهيك عن الخاصة، إذ يعتقدون أنه يجب أن يكون حضور المسيحية ومبادئها في الحياة أقوى وأظهر. وهذه الجماعة قريبة جدا من الفاتيكان، وهي على المستوى العقدي "أصولية راديكالية"... إنها نوع من الحركة المسيحية العالمية. وللأسف أن القارئ العربي لا يعرف كبير شيء عن هذه الجماعة الكبيرة و المؤثرة، وهي التي كانت –على سبيل المثال - تسيطر عبر وزرائها على خُمُس السلطة في الحكومة الأولى للرئيس الإسباني الأسبق أثنار.. فهي جماعة مؤثرة في الحزب الشعبي الحاكم بإسبانيا.
وكتب أحد الأساتذة المختصين في الجغرافيا عن مكانة الدين في الدستور الأوربي، ملاحظا أن الاتحاد يواجه صعوبات في تحديد قيمه الأساسية. لكن لا يمكن اعتبار الدستور الأوربي لائكيا بوضوح، إذ هو يعترف بمكانة للكنائس. وقد تجنب هذا الدستور الحسم في القضايا الدينية أو ذات العلاقة –كشؤون العدل والتربية- مفضلا تركها لكل بلد بحسب تقاليده وقوانينه وصيرورته التاريخية الخاصة. لكن هذا لم يمنع الكاتب من الاستنتاج بأن الدستور الأوربي يحمل بصمات البروتستانتية لا الكاثوليكية.
وكتب لاكومب عن علاقة الفاتيكان بالأمم المتحدة، فرغم أنه ليس دولة –بالمفهوم القانوني للدولة- إلا أن الفاتيكان نجح في ولوج الهيئة الأممية، وله دور في بعض مؤسساتها، مع اختياره فيها صفة مراقب فقط. واليوم يحتفظ الفاتيكان بعلاقات دبلوماسية مع أكثر دول العالم، وله صوته في القضايا الدولية الكبرى، خاصة الحقوقية والإنسانية منها.
الأرثذوكسية:
أما العلاقة بين الكنيستين الكاثوليكية والأرثذوكسية فليست على ما يرام.. ولهذا أسباب تاريخية متعددة ترجع إلى أيام الانقسام الأول بين الكنائس الشرقية والكنائس الكاثوليكية بالغرب، ثم حدث الشرخ النهائي في القرن الحادي عشر باستقلال كنيسة القسطنطينية نهائيا عن كنيسة روما.. لذا تلاحظ مثلا أن الرئيس بوتين لم يحضر جنازة البابا بولس الثاني، وذلك بضغط من البطريرك الروسي ألكسيس الثاني، فكنيسته ليست على وفاق مع الكنيسة الكاثوليكية التي يعتبرها بعض الروس أكثر حداثة من كنيستهم، كما يتخوف الأرثذوكس من انتشار الكثلكة في البلاد، ولذا لم يستطع البابا الراحل زيارة موسكو أبدا. والأمر مشابه لهذا في الصين حيث تخشى القيادة السياسية من توسع النصرانية، وحيث الكنيسة السرية القريبة من الفاتيكان أكثر أتباعا –فيما يبدو- من الكنيسة الرسمية.
ثم إن الكنيسة الأرثذوكسية نفسها تعرف خلافا داخليا خطرا. وهذا ما تناوله مقال عن الخلاف القائم اليوم بين بطركية موسكو وبطركية استانبول، ما قد يقسم الكنيسة الأرثذوكسية إلى قسمين: بطركية موسكو التي تجذب معها العالم السلافي والشرق أوربي، وبطركية استانبول ومعها العالم الهليني وكنائس الشرق العربي وإفريقيا... ولهذا آثاره السياسية أيضا.
وكتب كلاوكن –من المعهد الفرنسي للاستراتيجيا- عن العلاقة بين الدولة والكنيسة الأرثذوكسية بروسيا، وهي علاقة هادئة، بل تعاونية. وهذه عناصرها:
1- تعرف روسيا انبعاثا مزدوجا للهوية الوطنية وللمسيحية.. في إطار تأكيد الروس على فرادة حضارتهم ومصيرهم.
2- يعتقد كثير من رجال الدولة أن الأرثذوكسية من أهم عناصر الهوية الروسية، وأنها قادرة على تعويض الإيديولوجيا الماركسية. ولهذا وافق بوتين على إدخال مادة الثقافة الأرثذوكسية في التعليم، وهي اختيارية، كما وافق على عمل رجال الكنيسة بين الجيش.
3- كلا من بوتين والكنيسة لا يريد تدخل الغير فيما يعتبرانه أرضهم ومجال تأثيرهم، فلا بوتين يريد الغرب السياسي ولا بطريرك موسكو يقبل بوجود الغرب الكاثوليكي أو البروتستانتي. لهذا حصر قانون 1997 الديانات التقليدية –أي "المشروعة"- بروسيا في أربعة فقط: الأرثذوكسية، والإسلام، واليهودية، والبوذية.
قلت: هذا كله مفهوم ومتوقع، فروسيا لم تكن أبدا جزء من الغرب... جانب من الغرب كان جزء من روسيا كما كان جانب من الشرق الإسلامي ولا يزال جزء آخر منه، فروسيا عالم مستقل.. وقد أوضح ذلك جيدا المؤرخ الروسي بارتولد المتوفى سنة 1930 في عدد من كتبه، خاصة: تاريخ الاستشراق في أوربا وآسيا.
هذه بعض القضايا التي أوردتـُها هنا لإثارة انتباه الباحثين والدراسين إلى أهمية إنجاز دراسات عن عالم المسيحية بكنائسها المختلفة.إلياس بلكا
جيوبولتيك المسيحية:
إلياس بلكا
هذه خلاصات وتأملات على هامش قراءاتي لعدد سابق لمجلة "الدبلوماسية"، وهي فصلية تصدر باللغة الفرنسية، ومحور العدد مقالات حاولت الإجابة عن سؤال كبير، وهو: "هل للمسيحية اليوم استراتيجية عالمية ؟" عودة الأديان:
يؤكد صاحب مقال "المظاهر الجيوبولتيكية للمسيحية" على دور الدين في عصرنا، وأنه عامل سياسي واستراتيجي مهم جدا. وتعني جيوبولتيك علاقة السياسة بالجغرافيا، لذا نترجم الكلمة أحيانا بـ: الجغرافيا السياسية.
وفي هذا السياق كتب ألبريك لاكومب –باحث بمركز التحليل وتوقع المخاطر الدولية- خلاصة لإحدى الدراسات المستقبلية حول أوضاع الأديان في أفق سنة 2020، معززا ذلك بخريطة جغرافية استشرافية. وهذه أهم نتائج الدراسة: تقدم البروتستانتية في أمريكا الوسطى والجنوبية على حساب الكاثوليكية. وتقدم التبشير البروتستانتي والإنجيلي بإفريقيا الاستوائية والجنوبية. وتقدم الإسلام بآسيا الوسطى. ونمو الشعور الديني بروسيا والصين.
والملاحظة الأهم هنا هي أن مستقبل الدين –وفق هذه الدراسة- جيد، وأن صحوة عامة لمختلف الأديان قادمة. والمنطقة الوحيدة في العالم التي ستعرف تقدم اللادينية هي أوربا الغربية. وأقول: في 2020 أيضا –وما بعدها- سيكون وزن هذه المنطقة بالنسبة للعالم أقل وأضعف سكانيا واقتصاديا وسياسيا.
مشكلات الكنيسة الكاثوليكية:
يرى جون برنارد رايمون –وزير فرنسا السابق للشؤون الخارجية وسفيرها بالفاتيكان سابقا- أن من أهم التحديات التي على الكنيسة مواجهتها اليوم، خاصة الكاثوليكية: زواج القسس، والقضايا البيولوجية التي تثير أسئلة أخلاقية، والتقريب بين الكنائس المسيحية، وحوار الأديان (والمقصود هنا أساسا: الإسلام)، ومسألة الأرثذوكسية الروسية.
ويضيف تحديات أخرى، كمشكلة تراجع المسيحية والتديّن بها في بعض المناطق، وتحول الثقل العددي للمسيحية من الشمال إلى الجنوب، والتأثير المتصاعد للإنجيليين خصوصا بإفريقيا، والعلاقة مع الصين.
وتعرض مقال آخر لمنظمة أوبوس داي (أي عمل الله) التي ينتمي إليها أكثر من 85 ألف واحد في القارات الخمس، لا يشكل رجال الدين من بينهم أكثر من 2%. وهدف هذه المنظمة شبه السرية هو تمسيح الحياة العامة ناهيك عن الخاصة، إذ يعتقدون أنه يجب أن يكون حضور المسيحية ومبادئها في الحياة أقوى وأظهر. وهذه الجماعة قريبة جدا من الفاتيكان، وهي على المستوى العقدي "أصولية راديكالية"... إنها نوع من الحركة المسيحية العالمية. وللأسف أن القارئ العربي لا يعرف كبير شيء عن هذه الجماعة الكبيرة و المؤثرة، وهي التي كانت –على سبيل المثال - تسيطر عبر وزرائها على خُمُس السلطة في الحكومة الأولى للرئيس الإسباني الأسبق أثنار.. فهي جماعة مؤثرة في الحزب الشعبي الحاكم بإسبانيا.
وكتب أحد الأساتذة المختصين في الجغرافيا عن مكانة الدين في الدستور الأوربي، ملاحظا أن الاتحاد يواجه صعوبات في تحديد قيمه الأساسية. لكن لا يمكن اعتبار الدستور الأوربي لائكيا بوضوح، إذ هو يعترف بمكانة للكنائس. وقد تجنب هذا الدستور الحسم في القضايا الدينية أو ذات العلاقة –كشؤون العدل والتربية- مفضلا تركها لكل بلد بحسب تقاليده وقوانينه وصيرورته التاريخية الخاصة. لكن هذا لم يمنع الكاتب من الاستنتاج بأن الدستور الأوربي يحمل بصمات البروتستانتية لا الكاثوليكية.
وكتب لاكومب عن علاقة الفاتيكان بالأمم المتحدة، فرغم أنه ليس دولة –بالمفهوم القانوني للدولة- إلا أن الفاتيكان نجح في ولوج الهيئة الأممية، وله دور في بعض مؤسساتها، مع اختياره فيها صفة مراقب فقط. واليوم يحتفظ الفاتيكان بعلاقات دبلوماسية مع أكثر دول العالم، وله صوته في القضايا الدولية الكبرى، خاصة الحقوقية والإنسانية منها.
الأرثذوكسية:
أما العلاقة بين الكنيستين الكاثوليكية والأرثذوكسية فليست على ما يرام.. ولهذا أسباب تاريخية متعددة ترجع إلى أيام الانقسام الأول بين الكنائس الشرقية والكنائس الكاثوليكية بالغرب، ثم حدث الشرخ النهائي في القرن الحادي عشر باستقلال كنيسة القسطنطينية نهائيا عن كنيسة روما.. لذا تلاحظ مثلا أن الرئيس بوتين لم يحضر جنازة البابا بولس الثاني، وذلك بضغط من البطريرك الروسي ألكسيس الثاني، فكنيسته ليست على وفاق مع الكنيسة الكاثوليكية التي يعتبرها بعض الروس أكثر حداثة من كنيستهم، كما يتخوف الأرثذوكس من انتشار الكثلكة في البلاد، ولذا لم يستطع البابا الراحل زيارة موسكو أبدا. والأمر مشابه لهذا في الصين حيث تخشى القيادة السياسية من توسع النصرانية، وحيث الكنيسة السرية القريبة من الفاتيكان أكثر أتباعا –فيما يبدو- من الكنيسة الرسمية.
ثم إن الكنيسة الأرثذوكسية نفسها تعرف خلافا داخليا خطرا. وهذا ما تناوله مقال عن الخلاف القائم اليوم بين بطركية موسكو وبطركية استانبول، ما قد يقسم الكنيسة الأرثذوكسية إلى قسمين: بطركية موسكو التي تجذب معها العالم السلافي والشرق أوربي، وبطركية استانبول ومعها العالم الهليني وكنائس الشرق العربي وإفريقيا... ولهذا آثاره السياسية أيضا.
وكتب كلاوكن –من المعهد الفرنسي للاستراتيجيا- عن العلاقة بين الدولة والكنيسة الأرثذوكسية بروسيا، وهي علاقة هادئة، بل تعاونية. وهذه عناصرها:
1- تعرف روسيا انبعاثا مزدوجا للهوية الوطنية وللمسيحية.. في إطار تأكيد الروس على فرادة حضارتهم ومصيرهم.
2- يعتقد كثير من رجال الدولة أن الأرثذوكسية من أهم عناصر الهوية الروسية، وأنها قادرة على تعويض الإيديولوجيا الماركسية. ولهذا وافق بوتين على إدخال مادة الثقافة الأرثذوكسية في التعليم، وهي اختيارية، كما وافق على عمل رجال الكنيسة بين الجيش.
3- كلا من بوتين والكنيسة لا يريد تدخل الغير فيما يعتبرانه أرضهم ومجال تأثيرهم، فلا بوتين يريد الغرب السياسي ولا بطريرك موسكو يقبل بوجود الغرب الكاثوليكي أو البروتستانتي. لهذا حصر قانون 1997 الديانات التقليدية –أي "المشروعة"- بروسيا في أربعة فقط: الأرثذوكسية، والإسلام، واليهودية، والبوذية.
قلت: هذا كله مفهوم ومتوقع، فروسيا لم تكن أبدا جزء من الغرب... جانب من الغرب كان جزء من روسيا كما كان جانب من الشرق الإسلامي ولا يزال جزء آخر منه، فروسيا عالم مستقل.. وقد أوضح ذلك جيدا المؤرخ الروسي بارتولد المتوفى سنة 1930 في عدد من كتبه، خاصة: تاريخ الاستشراق في أوربا وآسيا.
هذه بعض القضايا التي أوردتـُها هنا لإثارة انتباه الباحثين والدراسين إلى أهمية إنجاز دراسات عن عالم المسيحية بكنائسها المختلفة.إلياس بلكا
Published on November 17, 2013 04:58
November 12, 2013
عقائد "نهاية العالم" في الفكر الغربي. (فكرة المخلص في المسيحية وبعض نتائجها في التاريخ الأوربي).
نشرت لي مجلة التسامح هذا المقال في وقت سابق (العدد الثامن):
لم يعد خافياً اليوم أن من أهم أسباب الدعم الغربي –والأمريكي خاصة- للكيان الصهيوني: العقيدة التي بمقتضاها سيعود المسيح عليه السلام مستقبلاً إلى الأرض، لكن من أهم شروط هذه العودة تجمع اليهود في القدس وما حولها. لذلك يلزم تشجيع هؤلاء على الاستقرار بفلسطين تمهيداً وإعداداً لظهور المخلِّص. هكذا تفكر طوائف مهمة ومؤثِّرة في الحياة السياسية الأمريكية(1).
ومن جهة ثالثة يعتقد الكثيرون في نهاية وشيكة للعالم، حيث يخْرُب كل شيء وينهار نظام الكون. وكلما أطل رأس قرن جديد أو ألفية جديدة ظن هؤلاء أن القيامة قاب قوسين أو أدنى. وتفصيل هذه المعتقدات وتأريخها وبيانها يتطلب تأليفاً مستقلاً، خصوصاً أنها متشابكة جداً. فغرضي في هذه المقالة هو أن أعرف القارئ ببعض أهم هذه الطوائف، وببعض الوقائع والأفكار التي ارتبطت بهذا النمط من النظر إلى المستقبل، حتى يكون على بينة من حيوية هذه الاعتقادات اليوم ومن تأثيرها على مجريات الأحداث الدولية.
رابط المقال، أو انظر أدناه(مزيد من المعلومات) http://www.altasamoh.net/Article.asp?...
عقائد "نهاية العالم" في الفكر الغربي [image error]إلياس بلكا* [image error] [image error] [image error]
لم يعد خافياً اليوم أن من أهم أسباب الدعم الغربي –والأمريكي خاصة- للكيان الصهيوني: العقيدة التي بمقتضاها سيعود المسيح عليه السلام مستقبلاً إلى الأرض، لكن من أهم شروط هذه العودة تجمع اليهود في القدس وما حولها. لذلك يلزم تشجيع هؤلاء على الاستقرار بفلسطين تمهيداً وإعداداً لظهور المخلِّص. هكذا تفكر طوائف مهمة ومؤثِّرة في الحياة السياسية الأمريكية(1).
ومن جهة ثانية، توجد جماعات دينية أخرى لا تعتقد في عودة المسيح، لكنها مع ذلك تبشّر بألفية سعيدة تنتظر البشرية، وتسعى إلى تدشينها بالثورة أو بالدعوة، أو بهما معا.
ومن جهة ثالثة يعتقد الكثيرون في نهاية وشيكة للعالم، حيث يخْرُب كل شيء وينهار نظام الكون. وكلما أطل رأس قرن جديد أو ألفية جديدة ظن هؤلاء أن القيامة قاب قوسين أو أدنى. وتفصيل هذه المعتقدات وتأريخها وبيانها يتطلب تأليفاً مستقلاً، خصوصاً أنها متشابكة جداً. فغرضي في هذه المقالة هو أن أعرف القارئ ببعض أهم هذه الطوائف، وببعض الوقائع والأفكار التي ارتبطت بهذا النمط من النظر إلى المستقبل، حتى يكون على بينة من حيوية هذه الاعتقادات اليوم ومن تأثيرها على مجريات الأحداث الدولية.عقيدة المخلّص:من الغريب فعلاً أن فكرة المخلص تكاد توجد في جميع الأديان الكبيرة(2). لكنها كانت أوضح ما تكون عند اليهود. يقول الحاخام شوكرون: إن العصر الذهبي للإنسانية لا يقع في ماضٍ غابرٍ وغامض، كما يعتقد الوثنيون، بل في المستقبل(3).قبل ظهور المخلص تكون اضطرابات كبيرة في العالم، ويتجمع شتات اليهود في أرضهم الأصلية (يعني فلسطين)، فتتأسس هناك إسرائيل من جديد، ويجيء المخلص، فتعود الهيمنة إلى التوراة، وتصبح القدس عاصمة العالم الروحية(4).آنذاك فقط يتحقق التوحيد الحق، وترتفع مملكة الله في الأرض كلها، ويسود السلام العالم، ويتوقف القتال(5).ويقول شوكرون: إن اليهود لم يعترفوا بأن المسيح هو المخلص، لأنه لم يحقق السلام والأخوة في العالم، ولم يُقِم مملكة الله في أرضه. ولذلك نحن نقول إن المخلص لم يأت بعد، فعلينا انتظاره، والكفاح لتقريب زمانه.يقول كاتب مقالة "المخلص" بالموسوعة: "إن رسالة محمد هي- من بين كل آمال اليهود القديمة في المخلص- الحدث الأكثر فجاءة والأشد إحباطاً لهم"(6).وقد انتقلت هذه العقيدة إلى المسيحية، حيث أصبح أصحاب هذا الدين الجديد ينتظرون عودة المسيح إليهم، أو ظهور مخلص آخر(7).ويظهر أن المسيحيين الأوائل شغلوا كثيرا بهذا الموضوع(8). وهذا الانشغال لا يزال مستمرا في طوائف كثيرة من المسيحيين إلى اليوم، خصوصا في طائفة المورومون التي تأسست بالولايات المتحدة سنة 1830م، وفي أتباع إيرفين الذين استقلوا بكنيسة خاصة. فهؤلاء كلهم يعيشون على أمل أن يشهدوا عودة المسيح عليه السلام(9). إضافة إلى طائفتي المجيئية وشهود يهوه كما سيأتي، وطوائف "المولودين ثانية" اليوم.الجماعات الألفية بالغرب:يقصد بهذه الجماعات مجموع الاتجاهات الدينية التي تعتقد أن الإنسانية توشك أن تدخل مرحلة جديدة –حوالي ألف سنة- من عمرها، حيث يعم السلام والرخاء العالم. وبعض هذه الاتجاهات تربط ذلك بعودة المسيح، وبعضها لا.مصدر هذا الفكر هو بالخصوص كتاب القيامة ليوحنا الذي يبشر في عبارات غامضة بهذه الألفية القادمة.وقد انتشرت هذه الحركات الألفية، وحاولت تحقيق هذا الوعد، باستعجاله(10). وكان هذا هو شعار الحرب الصليبية الأولى ضد المسلمين، لقد ذهب أولئك إلى القدس لتدشين ألفية المسيح. ثم تعددت المحاولات والثورات لأجل تحقيق هذا الهدف، من أهمها حركة طانشيلم بمنطقة أنفرس شمال بلجيكا حاليا، بين سنتي 1110 و 1115م. وحركة "أود النجم" بغرب فرنسا، من سنة 1140 إلى 1150م. وحركات أخرى في سنوات 1224، و 1251م(11).فلما جاء دوفلور أعطى لهذه الاتجاهات دفعة جديدة بتفسيره الخاص للتاريخ، حيث صرح –في شرحه لكتاب القيامة- بأن عصر روح القدس قد أقبل. والمفروض أن تكون بدايته سنة 1260م(12).في هذه السنة وبعدها نشأت حركات كثيرة أهمها كان في سنوات: 1295، 1300، 1307، 1420. وكان صدامها مع الكنيسة والحكام المدنيين كبيرا(13).وجاء عصر النهضة، وفيه حدثت أكبر محاولة "ألفية"، وهي الثورة الكبرى للفلاحين الألمان سنة 1525م، والتي انضم إليها مونزر –صديق لوثر-، وأسس في ولاية ويستفالي "مملكة القدس الجديدة"، ولكنها لم تدم طويلا(14).وكان لهذه الثورة أثرها على أوربا في القرن التاسع عشر، ولأهميتها درسها إنجلز في كتابه: ثورة الفلاحين(15).وفي نهاية القرن التاسع عشر تمخضت عن هذه الحركات الألفية المتنوعة جماعتان هامتان، لهما اليوم وجود كبير، وتعتبر عقيدة الألفية من عقائدهما الأساسية، وهما:1) المجيئية، أو السبتية. يقصد بهذا: المذهب الذي ينتظر رجوع المسيح عند آخر الزمان. ومؤسسه بأمريكا هو ميلر، الذي درس كتاب دانيال وكتاب القيامة، وتوصل بحساب الحروف إلى أن عودة المسيح إلى الأرض ستكون حوالـي 1843م.وقد انقسم أتباعه بسبب عدم تحقق هذه النبوءة، وأهم فرقهم: مجيئية اليوم السابع. وهؤلاء تبعوا امرأة تدعى إيلين كولد آرمون (1827- 1915م)، التي "تلقت" وحياً سماوياً بيّن لها متى ستقع بالضبط بشارات الأناجيل ونبوءاتها، كما بيّن لها أموراً تخص جماعتهم. ولذلك فتفسيرها للإنجيل مصدر مقدس بالنسبة لأتباعهـا(16).وعدد "المجيئيين" في تزايد مطرد، وفي أكثر أنحاء العالم، وقد انتقل عددهم سنة 1981م من ثلاثة ملايين عضو إلى ستة ملايين ونصف سنة 1988م، نسبة 70% منهم بآسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية(17).2) شهود يهوه: تأسست هذه الجماعة بالولايات المتحدة سنة 1874م على يد روسل، الذي اقتنع بأن عودة المسيح إلى العالم لن تكون مرئية ومشاهدة للناس، بل لا يراها إلا المؤمن، وبقلبه لا بعينه. وهذه العودة ستبدأ سنة 1874م، وبعدها بقليل تبدأ الألفية السعيدة(18).أخذ روسل يسافر كثيرا، ويجوب البلدان، داعياً إلى هذه الأفكار، ومبشراً بقرب الألفية المنتظرة، فاستجابت له جماعات من الناس، اتخذت لنفسها اسم "شهود يهوه"(19).بعد وفاة روسل خلفه القاضي روذفورد الذي كان له فضل بيان المذهب وتقعيده وتدوينه. وقد حدد هذا القاضي تاريخ 1925م لانبعاث الناس الأخيار، وعودتهم إلى الدنيا، ولأجلهم بنى منزلا بكاليفورنيا، لكنه مات سنة 1942م دون أن يرى أحداً من الموتى يسكن هذا المنزل(20).وشهود يهوه اليوم لا يحددون لهذه الألفية زمناً، بل يكتفون بالقول إنها قريبة. ولهم نشاط كبير في الدعاية لأفكارهم، حتى إنهم يطبعون كتبهم بملايين النسخ، ويترجمونها إلى عشرات اللغات. وعددهم حوالي مليونان ونصف، ربعهم بالولايات المتحدة(21).فهاتان الجماعتان أدمجتا "الفكر الألفي" في معتقداتهم، كما فعلت "الهيبي"، وبعض الحركات بأمريكا الجنوبية(22). لكن ما زالت توجد حركات أخرى حافظت على هذا الأمل في اقتراب زمان الألفية السعيدة، لكن هذا الاعتقاد لا يشكل جزءا من نسقها المذهبي، بل هو كل مذهبها ومحور أفكارها، وهي التي تسمى بـ: "الحركات الألفية" خاصة، Mouvements Millenaristes. ويوجد منهم بالاتحاد الأوربي أكثر من 300 ألف عضو، يتزايدون سنة بعد أخرى(23).نهاية العالم: أمثلة من العصر الوسيطشكّل موضوع أسباب سقوط إمبراطورية روما أحد أهم الإشكالات التاريخية التي وقف عندها مؤرخون وفلاسفة كثر، فتأملوها ودرسوها وأفردهـا بعضهم بالتصنيف(24). وهذا موضوع كبير لن أدخل فيه، لكن الذي أذكره هنا هو أن بعض الباحثين يقول: إن من أسباب سقوط الإمبراطورية انتشار العقيدة المسيحية حول قرب زمان القيامة وأن العالم يوشك أن ينهار. ولذلك عوض أن يحارب الناس لحماية الإمبراطورية، كانوا ينتظرون سقوطها. لقد ساهمت هذه العقائد في إضعاف روح الدفاع وغلبة مواقف السلبية والانتظار(25).وفي عام 575هـ الموافق لسنة 1179م أجمع المنجمون على أنه بعد سبع سنوات ستجتمع الكواكب في برج الميزان، ولما كان هذا البرج هوائيا، فسيترتب على هذا كارثة كبرى فتقع زلازل وعواصف ورياح شديدة، ويكون ذلك نوعا من الطوفان الهوائي، كما كان في عهد نوح -عليه السلام- طوفان مائي باجتماع الكواكب في برج الحوت(26).ويبدو أن خبر هذا التنبؤ انتقل من العالم الإسلامي إلى الأندلس، ومنها إلى أوربا، وذلك عن طريق مجموعة كتابات عُرفت بـ"رسائل جون الطليطلي"، وكان هذا سنة 1179م(27).وجاءت ليلة اليوم الموعود في سنة 582هـ، سبتمبر عام 1186م، وفعلا تجمعت الكواكب في برج الميزان، ومع ذلك لم تر ليلة مثل الموعودة في سكونها وهدوئها، وقل هبوب الرياح على خلاف عادتها، حتى قلق الناس لذلك(28).والمقصود هنا أن وقع هذا الخبر على أوربا كان شديدا، وأحدث فيها نوعا من الفوضى العامة: في ألمانيا حفر الناس الكهوف، وأمر الأسقف الأكبر بالصيام، وفي بيزنطة تم سد نوافذ القصر الإمبراطوري. وانتشر الرعب في الناس(29).وفي سنة 1499م تنبأ ستوفلر بأن طوفاناً جديداً سيحدث في شهر فبراير 1524م؛ لأن كواكب كثيرة ستكون آنذاك ببرج رطب. ولما اقترب هذا الوقت انتشرت الفوضى، وطلب الناس من بعض الملوك أن يحددوا ملاجئ يهربون إليها وتجمع الكثيرون انتظارا للخطر القادم، وكثيرون باعوا منازلهم وأثاثهم ولجؤوا إلى السفن. جاء فبراير 1524م، وكان شهر جفاف ممتاز قل نظيره(30).مثالٌ حديث: سنة 2000 عام النهاية:وهذا من أحدث الأمثلة في موضوعنا هذا. لقد قال أحد العرافين: "خلال عام 1999م، وتحديدا في يوليو، ستقع أحداث ستقع أحداث كونية كبرى، ستهز البشرية كلها، وستكون أمرا عظيما. ستكون إما انفجارات نووية أو سقوط نيازك من السماء ستمس البشرية كلها، وستقضي على ثلاثة أرباع الحياة الإنسانية"(31).وقد اعتقدت طوائف من المسيحيين أن العالم سينتهي حوالي سنة 2000م، أي على رأس الألفية الثالثة، فسارعت إلى الاستعداد لذلك بالانتحار واللحاق بالسماء. ومن الأمثلة المؤسفة لهذا ما وقع بأوغندا يوم 17 مارس 2000م حيث قامت الطائفة بتفجير الكنيسة وإحراقها في انتحار جماعي، وصل عدد ضحاياه إلى 530 قتيلا بما فيهم 78 طفلا. وكان من بين المنتحرين زعيم الطائفة الكنسية كيبويتر واثنان من معاونيه(32).*************الهوامش*) أستاذ وباحث أكاديمي من المغرب.1- انظر مقال: (السلام مستحيل قبل ظهور المخلَّص) بشهرية العالم السياسي، ملحق لوموند بالفرنسية:Le monde diplomatique, Septembere2002, p10-11.2- انظر: المعتقدات الدينية لدى الشعوب، ص176- 177. (مقال مذهب انتظار المخلص بالموسوعة الفرنسية): Encyclopaedia Universalis, article Messianisme.15/8. وقارن ذلك بالفصل الطويل في بيان بشارات التوراة الإنجيل بمحمد، والذي كتبه رشيد رضا في: تفسير المنار، 9/ 221 فما بعدها، الأعراف 157.3- في كتابه: (ترجمة العنوان: اليهودية: المعتقدات والمبادئ) Le judaisme, doctrines et preceptes, p504- Le judaisme,p 59-605- Le judaisme,p 606- Le judaisme,p 617- تكاد المسيحية تكون ديانة تاريخية تحمل رؤية نهائية عن مراحل الوجود البشري. وهذا ما شجع على ظهور الحركات الألفية والمخلصة وأفكار النهايات. راجع في الطابع التاريخي لهذا الدين. (تاريخ الفلسفة). Histoire de la philosophie, 6/p7a8- (التاريخ المختص للمسيحية) Courte histoire du christianisme, p22.9- Courte histoire du christianisme, p99 (والمذكور Edouard Irving واعظ اسكتلندي توفي سنة 1834).10- (مقال عقيدة الألفية) Encyclopaedia Universalis. Article Millenarisme, 15/37411- 375/ 15. Encyclopaedia. Uni. Art. Millenarisme Eudes de L’Etoile. Tachelm)12- L’Ency. Uni 375/ 15/L’esoterisme, p38 -13-’ Art. Millenarisme13- 375/ 15. L’Ency. Uni. Art. Millenarisme. L’esoterisme, p3814- 375/ 15. L’Ency. Uni. Art. Millenarisme 15- 375/ 15. L’Ency. Uni. Art. Millenarisme وThomas Munzer من المصلحين الدينيين الألمان، درس الإلهيات الوسيطة والفكر الإنساني للنهضة. وأعدم عقب الثورة سنة 1525.16- Ency. Uni. Art. Millenarisme. Et article Messiansime. 15/817- 294- 293/1 Ency. Uni. Article: L’Adventisme, اسم هؤلاء: eme jour 7 Les adventistes (Wiliam Miller 1782- 1849)18- 294/1 Ency. Uni. Art: Adventisme. المرأة: Ellen Gould Harmon19- 254/ 22. Ency. Uni.Art: Temoins de Jehovah. المؤسس: (1825-1916) Charles Taze Russell20- Ency. Uni, Art: Temoins de Jehovah. 22/ 25421- 254/ 22. article: Temoins de Jehovah. القاضي: J.F. Rutherford22- 254/ 22. Art Temoins de Jehovah23- 376/ 15. Ency. Uni. Art Millenarisme 24- (مقال: المجتمع واللاعقلانية بشهرية العالم السياسي)Article: Irrationnel et Societe. In: Le Monde Diolomatique P28. September. 1997. 25-منهم مونتيسكيو في كتابه: تأملات حول أسباب عظمة روما وانحطاطها.26- راجع: 41-42 Courte Histoire du Christianisme27- هذا الخبر ورد في مصادر إسلامية وأوربية، انظر: الكامل في التاريخ لعز الدين بن الأثير، 9/ 174-175. حوادث سنة 582.مفتاح دار السعادة ص459- 460. وقارن بـ: Quelques sciences captivantes. P 206. L’astrologie. P97 28- انظر: L’astrologie. P9729- مفتاح دار السعادة صL’astrologie P97. Quelques sciences captivantes. P206.45930- L’astrologie, p97. Quelques sciences captivantes. P20631- L’astrologie. P/ 98 المتكهن هو: Johanne’s Stoffler 32- راجع اليومية الدولية العربية: "الحياة"، يوم 10 سبتمبر 1997، الصفحة الأخيرة33- تناقلت وسائل الإعلام الدولية هذا الخبر في حينه – انظر مثلا:Article: Uganda Cult blaze Death toll put at 530. In: Arab News, 23 March 2000. P3
المراجع1) تفسير المنار، لرشيد رضا. دار المعرفة، بيروت طبعة ثانية.2) الكامل في التاريخ، لعز الدين بن الأثير، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 2، 1967.3) مفتاح دار السعادة، لأبي عبد الله ابن القيم. دار الكتاب العلمية، بيروت، 1998.4) المعتقدات الدينية لدى الشعوب، لجفري بارندر، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، سلسلة عالم المعرفة. عدد 173، 1993، الكويت.5) جريدة الحياة، رئيس التحرير جهاد الخازن. لندن.6) Boll, Marcel: Cluelques sciences captivantes, Editions du Sagittaine, france, 1941.7) Brehier, Emile: Histoire de la philosophie, Ceres Edition, Tunis. 1994. 8) Coudae, Paul: L’astrologie. Presses de France, 1 ed, 1951.9) Choucroun, I.n: Le Judaisme, doctrines et preceptes, collection: Aythes et religious. Presses de France, Paris, 1 ed, 1951, 10) Houtin, Allert: Courte histoire du christianisme. F. Reider et cie editeurs. Paris, 1 ed 1924. 11) Arabe News, Jeddah, Arabe Saudite.12) Le Monde diplomatique, Paris, directeur Ignacio Ramonet.
لم يعد خافياً اليوم أن من أهم أسباب الدعم الغربي –والأمريكي خاصة- للكيان الصهيوني: العقيدة التي بمقتضاها سيعود المسيح عليه السلام مستقبلاً إلى الأرض، لكن من أهم شروط هذه العودة تجمع اليهود في القدس وما حولها. لذلك يلزم تشجيع هؤلاء على الاستقرار بفلسطين تمهيداً وإعداداً لظهور المخلِّص. هكذا تفكر طوائف مهمة ومؤثِّرة في الحياة السياسية الأمريكية(1).
ومن جهة ثالثة يعتقد الكثيرون في نهاية وشيكة للعالم، حيث يخْرُب كل شيء وينهار نظام الكون. وكلما أطل رأس قرن جديد أو ألفية جديدة ظن هؤلاء أن القيامة قاب قوسين أو أدنى. وتفصيل هذه المعتقدات وتأريخها وبيانها يتطلب تأليفاً مستقلاً، خصوصاً أنها متشابكة جداً. فغرضي في هذه المقالة هو أن أعرف القارئ ببعض أهم هذه الطوائف، وببعض الوقائع والأفكار التي ارتبطت بهذا النمط من النظر إلى المستقبل، حتى يكون على بينة من حيوية هذه الاعتقادات اليوم ومن تأثيرها على مجريات الأحداث الدولية.
رابط المقال، أو انظر أدناه(مزيد من المعلومات) http://www.altasamoh.net/Article.asp?...
عقائد "نهاية العالم" في الفكر الغربي [image error]إلياس بلكا* [image error] [image error] [image error]
لم يعد خافياً اليوم أن من أهم أسباب الدعم الغربي –والأمريكي خاصة- للكيان الصهيوني: العقيدة التي بمقتضاها سيعود المسيح عليه السلام مستقبلاً إلى الأرض، لكن من أهم شروط هذه العودة تجمع اليهود في القدس وما حولها. لذلك يلزم تشجيع هؤلاء على الاستقرار بفلسطين تمهيداً وإعداداً لظهور المخلِّص. هكذا تفكر طوائف مهمة ومؤثِّرة في الحياة السياسية الأمريكية(1).
ومن جهة ثانية، توجد جماعات دينية أخرى لا تعتقد في عودة المسيح، لكنها مع ذلك تبشّر بألفية سعيدة تنتظر البشرية، وتسعى إلى تدشينها بالثورة أو بالدعوة، أو بهما معا.
ومن جهة ثالثة يعتقد الكثيرون في نهاية وشيكة للعالم، حيث يخْرُب كل شيء وينهار نظام الكون. وكلما أطل رأس قرن جديد أو ألفية جديدة ظن هؤلاء أن القيامة قاب قوسين أو أدنى. وتفصيل هذه المعتقدات وتأريخها وبيانها يتطلب تأليفاً مستقلاً، خصوصاً أنها متشابكة جداً. فغرضي في هذه المقالة هو أن أعرف القارئ ببعض أهم هذه الطوائف، وببعض الوقائع والأفكار التي ارتبطت بهذا النمط من النظر إلى المستقبل، حتى يكون على بينة من حيوية هذه الاعتقادات اليوم ومن تأثيرها على مجريات الأحداث الدولية.عقيدة المخلّص:من الغريب فعلاً أن فكرة المخلص تكاد توجد في جميع الأديان الكبيرة(2). لكنها كانت أوضح ما تكون عند اليهود. يقول الحاخام شوكرون: إن العصر الذهبي للإنسانية لا يقع في ماضٍ غابرٍ وغامض، كما يعتقد الوثنيون، بل في المستقبل(3).قبل ظهور المخلص تكون اضطرابات كبيرة في العالم، ويتجمع شتات اليهود في أرضهم الأصلية (يعني فلسطين)، فتتأسس هناك إسرائيل من جديد، ويجيء المخلص، فتعود الهيمنة إلى التوراة، وتصبح القدس عاصمة العالم الروحية(4).آنذاك فقط يتحقق التوحيد الحق، وترتفع مملكة الله في الأرض كلها، ويسود السلام العالم، ويتوقف القتال(5).ويقول شوكرون: إن اليهود لم يعترفوا بأن المسيح هو المخلص، لأنه لم يحقق السلام والأخوة في العالم، ولم يُقِم مملكة الله في أرضه. ولذلك نحن نقول إن المخلص لم يأت بعد، فعلينا انتظاره، والكفاح لتقريب زمانه.يقول كاتب مقالة "المخلص" بالموسوعة: "إن رسالة محمد هي- من بين كل آمال اليهود القديمة في المخلص- الحدث الأكثر فجاءة والأشد إحباطاً لهم"(6).وقد انتقلت هذه العقيدة إلى المسيحية، حيث أصبح أصحاب هذا الدين الجديد ينتظرون عودة المسيح إليهم، أو ظهور مخلص آخر(7).ويظهر أن المسيحيين الأوائل شغلوا كثيرا بهذا الموضوع(8). وهذا الانشغال لا يزال مستمرا في طوائف كثيرة من المسيحيين إلى اليوم، خصوصا في طائفة المورومون التي تأسست بالولايات المتحدة سنة 1830م، وفي أتباع إيرفين الذين استقلوا بكنيسة خاصة. فهؤلاء كلهم يعيشون على أمل أن يشهدوا عودة المسيح عليه السلام(9). إضافة إلى طائفتي المجيئية وشهود يهوه كما سيأتي، وطوائف "المولودين ثانية" اليوم.الجماعات الألفية بالغرب:يقصد بهذه الجماعات مجموع الاتجاهات الدينية التي تعتقد أن الإنسانية توشك أن تدخل مرحلة جديدة –حوالي ألف سنة- من عمرها، حيث يعم السلام والرخاء العالم. وبعض هذه الاتجاهات تربط ذلك بعودة المسيح، وبعضها لا.مصدر هذا الفكر هو بالخصوص كتاب القيامة ليوحنا الذي يبشر في عبارات غامضة بهذه الألفية القادمة.وقد انتشرت هذه الحركات الألفية، وحاولت تحقيق هذا الوعد، باستعجاله(10). وكان هذا هو شعار الحرب الصليبية الأولى ضد المسلمين، لقد ذهب أولئك إلى القدس لتدشين ألفية المسيح. ثم تعددت المحاولات والثورات لأجل تحقيق هذا الهدف، من أهمها حركة طانشيلم بمنطقة أنفرس شمال بلجيكا حاليا، بين سنتي 1110 و 1115م. وحركة "أود النجم" بغرب فرنسا، من سنة 1140 إلى 1150م. وحركات أخرى في سنوات 1224، و 1251م(11).فلما جاء دوفلور أعطى لهذه الاتجاهات دفعة جديدة بتفسيره الخاص للتاريخ، حيث صرح –في شرحه لكتاب القيامة- بأن عصر روح القدس قد أقبل. والمفروض أن تكون بدايته سنة 1260م(12).في هذه السنة وبعدها نشأت حركات كثيرة أهمها كان في سنوات: 1295، 1300، 1307، 1420. وكان صدامها مع الكنيسة والحكام المدنيين كبيرا(13).وجاء عصر النهضة، وفيه حدثت أكبر محاولة "ألفية"، وهي الثورة الكبرى للفلاحين الألمان سنة 1525م، والتي انضم إليها مونزر –صديق لوثر-، وأسس في ولاية ويستفالي "مملكة القدس الجديدة"، ولكنها لم تدم طويلا(14).وكان لهذه الثورة أثرها على أوربا في القرن التاسع عشر، ولأهميتها درسها إنجلز في كتابه: ثورة الفلاحين(15).وفي نهاية القرن التاسع عشر تمخضت عن هذه الحركات الألفية المتنوعة جماعتان هامتان، لهما اليوم وجود كبير، وتعتبر عقيدة الألفية من عقائدهما الأساسية، وهما:1) المجيئية، أو السبتية. يقصد بهذا: المذهب الذي ينتظر رجوع المسيح عند آخر الزمان. ومؤسسه بأمريكا هو ميلر، الذي درس كتاب دانيال وكتاب القيامة، وتوصل بحساب الحروف إلى أن عودة المسيح إلى الأرض ستكون حوالـي 1843م.وقد انقسم أتباعه بسبب عدم تحقق هذه النبوءة، وأهم فرقهم: مجيئية اليوم السابع. وهؤلاء تبعوا امرأة تدعى إيلين كولد آرمون (1827- 1915م)، التي "تلقت" وحياً سماوياً بيّن لها متى ستقع بالضبط بشارات الأناجيل ونبوءاتها، كما بيّن لها أموراً تخص جماعتهم. ولذلك فتفسيرها للإنجيل مصدر مقدس بالنسبة لأتباعهـا(16).وعدد "المجيئيين" في تزايد مطرد، وفي أكثر أنحاء العالم، وقد انتقل عددهم سنة 1981م من ثلاثة ملايين عضو إلى ستة ملايين ونصف سنة 1988م، نسبة 70% منهم بآسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية(17).2) شهود يهوه: تأسست هذه الجماعة بالولايات المتحدة سنة 1874م على يد روسل، الذي اقتنع بأن عودة المسيح إلى العالم لن تكون مرئية ومشاهدة للناس، بل لا يراها إلا المؤمن، وبقلبه لا بعينه. وهذه العودة ستبدأ سنة 1874م، وبعدها بقليل تبدأ الألفية السعيدة(18).أخذ روسل يسافر كثيرا، ويجوب البلدان، داعياً إلى هذه الأفكار، ومبشراً بقرب الألفية المنتظرة، فاستجابت له جماعات من الناس، اتخذت لنفسها اسم "شهود يهوه"(19).بعد وفاة روسل خلفه القاضي روذفورد الذي كان له فضل بيان المذهب وتقعيده وتدوينه. وقد حدد هذا القاضي تاريخ 1925م لانبعاث الناس الأخيار، وعودتهم إلى الدنيا، ولأجلهم بنى منزلا بكاليفورنيا، لكنه مات سنة 1942م دون أن يرى أحداً من الموتى يسكن هذا المنزل(20).وشهود يهوه اليوم لا يحددون لهذه الألفية زمناً، بل يكتفون بالقول إنها قريبة. ولهم نشاط كبير في الدعاية لأفكارهم، حتى إنهم يطبعون كتبهم بملايين النسخ، ويترجمونها إلى عشرات اللغات. وعددهم حوالي مليونان ونصف، ربعهم بالولايات المتحدة(21).فهاتان الجماعتان أدمجتا "الفكر الألفي" في معتقداتهم، كما فعلت "الهيبي"، وبعض الحركات بأمريكا الجنوبية(22). لكن ما زالت توجد حركات أخرى حافظت على هذا الأمل في اقتراب زمان الألفية السعيدة، لكن هذا الاعتقاد لا يشكل جزءا من نسقها المذهبي، بل هو كل مذهبها ومحور أفكارها، وهي التي تسمى بـ: "الحركات الألفية" خاصة، Mouvements Millenaristes. ويوجد منهم بالاتحاد الأوربي أكثر من 300 ألف عضو، يتزايدون سنة بعد أخرى(23).نهاية العالم: أمثلة من العصر الوسيطشكّل موضوع أسباب سقوط إمبراطورية روما أحد أهم الإشكالات التاريخية التي وقف عندها مؤرخون وفلاسفة كثر، فتأملوها ودرسوها وأفردهـا بعضهم بالتصنيف(24). وهذا موضوع كبير لن أدخل فيه، لكن الذي أذكره هنا هو أن بعض الباحثين يقول: إن من أسباب سقوط الإمبراطورية انتشار العقيدة المسيحية حول قرب زمان القيامة وأن العالم يوشك أن ينهار. ولذلك عوض أن يحارب الناس لحماية الإمبراطورية، كانوا ينتظرون سقوطها. لقد ساهمت هذه العقائد في إضعاف روح الدفاع وغلبة مواقف السلبية والانتظار(25).وفي عام 575هـ الموافق لسنة 1179م أجمع المنجمون على أنه بعد سبع سنوات ستجتمع الكواكب في برج الميزان، ولما كان هذا البرج هوائيا، فسيترتب على هذا كارثة كبرى فتقع زلازل وعواصف ورياح شديدة، ويكون ذلك نوعا من الطوفان الهوائي، كما كان في عهد نوح -عليه السلام- طوفان مائي باجتماع الكواكب في برج الحوت(26).ويبدو أن خبر هذا التنبؤ انتقل من العالم الإسلامي إلى الأندلس، ومنها إلى أوربا، وذلك عن طريق مجموعة كتابات عُرفت بـ"رسائل جون الطليطلي"، وكان هذا سنة 1179م(27).وجاءت ليلة اليوم الموعود في سنة 582هـ، سبتمبر عام 1186م، وفعلا تجمعت الكواكب في برج الميزان، ومع ذلك لم تر ليلة مثل الموعودة في سكونها وهدوئها، وقل هبوب الرياح على خلاف عادتها، حتى قلق الناس لذلك(28).والمقصود هنا أن وقع هذا الخبر على أوربا كان شديدا، وأحدث فيها نوعا من الفوضى العامة: في ألمانيا حفر الناس الكهوف، وأمر الأسقف الأكبر بالصيام، وفي بيزنطة تم سد نوافذ القصر الإمبراطوري. وانتشر الرعب في الناس(29).وفي سنة 1499م تنبأ ستوفلر بأن طوفاناً جديداً سيحدث في شهر فبراير 1524م؛ لأن كواكب كثيرة ستكون آنذاك ببرج رطب. ولما اقترب هذا الوقت انتشرت الفوضى، وطلب الناس من بعض الملوك أن يحددوا ملاجئ يهربون إليها وتجمع الكثيرون انتظارا للخطر القادم، وكثيرون باعوا منازلهم وأثاثهم ولجؤوا إلى السفن. جاء فبراير 1524م، وكان شهر جفاف ممتاز قل نظيره(30).مثالٌ حديث: سنة 2000 عام النهاية:وهذا من أحدث الأمثلة في موضوعنا هذا. لقد قال أحد العرافين: "خلال عام 1999م، وتحديدا في يوليو، ستقع أحداث ستقع أحداث كونية كبرى، ستهز البشرية كلها، وستكون أمرا عظيما. ستكون إما انفجارات نووية أو سقوط نيازك من السماء ستمس البشرية كلها، وستقضي على ثلاثة أرباع الحياة الإنسانية"(31).وقد اعتقدت طوائف من المسيحيين أن العالم سينتهي حوالي سنة 2000م، أي على رأس الألفية الثالثة، فسارعت إلى الاستعداد لذلك بالانتحار واللحاق بالسماء. ومن الأمثلة المؤسفة لهذا ما وقع بأوغندا يوم 17 مارس 2000م حيث قامت الطائفة بتفجير الكنيسة وإحراقها في انتحار جماعي، وصل عدد ضحاياه إلى 530 قتيلا بما فيهم 78 طفلا. وكان من بين المنتحرين زعيم الطائفة الكنسية كيبويتر واثنان من معاونيه(32).*************الهوامش*) أستاذ وباحث أكاديمي من المغرب.1- انظر مقال: (السلام مستحيل قبل ظهور المخلَّص) بشهرية العالم السياسي، ملحق لوموند بالفرنسية:Le monde diplomatique, Septembere2002, p10-11.2- انظر: المعتقدات الدينية لدى الشعوب، ص176- 177. (مقال مذهب انتظار المخلص بالموسوعة الفرنسية): Encyclopaedia Universalis, article Messianisme.15/8. وقارن ذلك بالفصل الطويل في بيان بشارات التوراة الإنجيل بمحمد، والذي كتبه رشيد رضا في: تفسير المنار، 9/ 221 فما بعدها، الأعراف 157.3- في كتابه: (ترجمة العنوان: اليهودية: المعتقدات والمبادئ) Le judaisme, doctrines et preceptes, p504- Le judaisme,p 59-605- Le judaisme,p 606- Le judaisme,p 617- تكاد المسيحية تكون ديانة تاريخية تحمل رؤية نهائية عن مراحل الوجود البشري. وهذا ما شجع على ظهور الحركات الألفية والمخلصة وأفكار النهايات. راجع في الطابع التاريخي لهذا الدين. (تاريخ الفلسفة). Histoire de la philosophie, 6/p7a8- (التاريخ المختص للمسيحية) Courte histoire du christianisme, p22.9- Courte histoire du christianisme, p99 (والمذكور Edouard Irving واعظ اسكتلندي توفي سنة 1834).10- (مقال عقيدة الألفية) Encyclopaedia Universalis. Article Millenarisme, 15/37411- 375/ 15. Encyclopaedia. Uni. Art. Millenarisme Eudes de L’Etoile. Tachelm)12- L’Ency. Uni 375/ 15/L’esoterisme, p38 -13-’ Art. Millenarisme13- 375/ 15. L’Ency. Uni. Art. Millenarisme. L’esoterisme, p3814- 375/ 15. L’Ency. Uni. Art. Millenarisme 15- 375/ 15. L’Ency. Uni. Art. Millenarisme وThomas Munzer من المصلحين الدينيين الألمان، درس الإلهيات الوسيطة والفكر الإنساني للنهضة. وأعدم عقب الثورة سنة 1525.16- Ency. Uni. Art. Millenarisme. Et article Messiansime. 15/817- 294- 293/1 Ency. Uni. Article: L’Adventisme, اسم هؤلاء: eme jour 7 Les adventistes (Wiliam Miller 1782- 1849)18- 294/1 Ency. Uni. Art: Adventisme. المرأة: Ellen Gould Harmon19- 254/ 22. Ency. Uni.Art: Temoins de Jehovah. المؤسس: (1825-1916) Charles Taze Russell20- Ency. Uni, Art: Temoins de Jehovah. 22/ 25421- 254/ 22. article: Temoins de Jehovah. القاضي: J.F. Rutherford22- 254/ 22. Art Temoins de Jehovah23- 376/ 15. Ency. Uni. Art Millenarisme 24- (مقال: المجتمع واللاعقلانية بشهرية العالم السياسي)Article: Irrationnel et Societe. In: Le Monde Diolomatique P28. September. 1997. 25-منهم مونتيسكيو في كتابه: تأملات حول أسباب عظمة روما وانحطاطها.26- راجع: 41-42 Courte Histoire du Christianisme27- هذا الخبر ورد في مصادر إسلامية وأوربية، انظر: الكامل في التاريخ لعز الدين بن الأثير، 9/ 174-175. حوادث سنة 582.مفتاح دار السعادة ص459- 460. وقارن بـ: Quelques sciences captivantes. P 206. L’astrologie. P97 28- انظر: L’astrologie. P9729- مفتاح دار السعادة صL’astrologie P97. Quelques sciences captivantes. P206.45930- L’astrologie, p97. Quelques sciences captivantes. P20631- L’astrologie. P/ 98 المتكهن هو: Johanne’s Stoffler 32- راجع اليومية الدولية العربية: "الحياة"، يوم 10 سبتمبر 1997، الصفحة الأخيرة33- تناقلت وسائل الإعلام الدولية هذا الخبر في حينه – انظر مثلا:Article: Uganda Cult blaze Death toll put at 530. In: Arab News, 23 March 2000. P3
المراجع1) تفسير المنار، لرشيد رضا. دار المعرفة، بيروت طبعة ثانية.2) الكامل في التاريخ، لعز الدين بن الأثير، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 2، 1967.3) مفتاح دار السعادة، لأبي عبد الله ابن القيم. دار الكتاب العلمية، بيروت، 1998.4) المعتقدات الدينية لدى الشعوب، لجفري بارندر، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، سلسلة عالم المعرفة. عدد 173، 1993، الكويت.5) جريدة الحياة، رئيس التحرير جهاد الخازن. لندن.6) Boll, Marcel: Cluelques sciences captivantes, Editions du Sagittaine, france, 1941.7) Brehier, Emile: Histoire de la philosophie, Ceres Edition, Tunis. 1994. 8) Coudae, Paul: L’astrologie. Presses de France, 1 ed, 1951.9) Choucroun, I.n: Le Judaisme, doctrines et preceptes, collection: Aythes et religious. Presses de France, Paris, 1 ed, 1951, 10) Houtin, Allert: Courte histoire du christianisme. F. Reider et cie editeurs. Paris, 1 ed 1924. 11) Arabe News, Jeddah, Arabe Saudite.12) Le Monde diplomatique, Paris, directeur Ignacio Ramonet.
Published on November 12, 2013 07:26
November 11, 2013
د. حمدي عبد الرحمن: تحديات قمة الكويت الأفروعربية الثالثة .. 19 نوفمبر 2013 .

تحديات قمة الكويت الأفروعربية الثالثة .. 19 نوفمبر 2013
الإثنين هـ - 11 نوفمبر 2013م
بقلم : حمدي عبد الرحمن
يلاحظ المتابع لمسيرة العلاقات الأفريقية العربية من نحو خمسين عاماً خلت أنها تطرح دائماً اشكالية الفرص الضائعة، ربما بسبب غلبة السياسي على الاقتصادي في الحوار الاستراتيجي بين العالمين العربي أو الأفريقي أو بسبب التكالب الدولي المستمر على اكتساب الثروة والنفوذ في الفضاء الأفروعربي. وإذا نحينا جانباً عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين العرب والأفارقة، والتي كانت محوراً لدراسات وبحوث تاريخية معتبرة حتى ذهب المفكر الكيني الأبرز علي مزروعي إلى القول بارتباط شبه الجزيرة العربية عضوياً بأفريقيا قبل تشكل البحر الأحمر، فإن العديد من المتغيرات والتحديات المعاصرة تدفع إلى ضرورة الشراكة الاستراتيجية بين العرب والأفارقة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لقد مثلت قضايا الاستعمار وتحديات بناء الدولة الوطنية واستلهام روح عدم الانحياز وباندونج بالاضافة إلى اقتصاديات مياه النيل واشكاليات الصراع والتنمية المستدامة في ظل سياسات العولمة وإعادة انتاج سياسات الهيمنة الاستراتيجية على الصعيد الدولي أبرز محاور الحوار الاستراتيجي بين العرب والأفارقة. وعليه فقد كانت أخطاء أعوام السبعينيات حجر عثرة أمام تنفيذ آليات العمل العربي الأفريقي المشترك التي أقرتها القمة الأفروعربية الأولى في القاهرة عام 1977. ومن جهة أخرى فإن شحصية العقيد الليبي الراحل معمر القذافي ورغبته في القيادة والسيطرة قد دفعت بقمة سرت الأفروعربية الثانية عام 2010 لتصبح مجرد منبر إعلامي لا يتجاوز دلالاته الرمزية والسياسية.
فهل يمكن القول بأن القمة الأفروعربية الثالثة التي تعقد في الكويت يومي 19و20 نوفمبر 2013 تشكل تحولاً فارقاً في الوعي العربي الأفريقي المشترك؟ وهل يمكن لها في ظل التحديات الهائلة التي يواجهها النظامين الاقليميين العربي والأفريقي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة أن تعزز من قدرات الطرفين في تحقيق آمال وطموحات الشعوب العربية والأفريقية؟
وفي سعينا للاجابة على هذين السؤالين نحاول طرح ثلاثة قضايا أساسية تناقش أولها طبيعة البيئة الداخلية والاقليمية والدولية السائدة والتي تضفي أهمية خاصة على قمة الكويت الأفروعربية، أما القضية الثانية فإنها تناقش دروس الماضي بهدف تصويب مسيرة التعاون العربي الأفريقي، والقضية الثالثة تستشرف آفاق المستقبل.
قمة الكويت وجدلية التحدي والاستجابة:لعل من المفارقات التي تثير التعجب والاستغراب في آن واحد هو تأخر هذه القمة بنحو 33 عاماً حيث كان من المقرر أن تعقد القمة الأفروعربية الثانية في الكويت عام 1980، أي بعد أعوام ثلاثة من قمة القاهرة الأولى. ومن جانب آخر فإن مصر التي احتضنت حركة الوحدة الأفريقية وأسهمت بدور محوري في تبني منظومة التعاون العربي الأفريقي، من خلال استضافتها للقمة الأفروعربية الأولى في القاهرة تجد نفسها اليوم وهي تحضر قمة الكويت باعتبارها أحد أعضاء الجامعة العربية وفقط، نظراً لتجميد عضويتها في الاتحاد الأفريقي في أعقاب الاطاحة بنظام الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013.
وعلى أية حال فإن خصوصية وأهمية قمة الكويت الأفروعربية الثالثة تنبع من عدة اعتبارات أساسية لعل من أبرزها:أولاً: التغيرات العارمة التي شهدها النظام الاقليمي العربي في عام 2011 بعد ثورات الربيع العربي التي انطلقت في مصر وتونس وليبيا وسوريا واليمن وغيرها من الدول العربية. ولعل الدلالة الكبرى هنا تشير إلى مدى تلاحم الدول العربية والأفريقية في التطلع نحو التحرر السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وأحسب أن الربيع الأفريقي الذي بدأ في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي يسبق ربيع العرب، وهو ما يعني إمكانية استلهام بعض تجارب وقصص النجاح الأفريقية الكبرى مثل غانا وبوتسوانا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا.
ثانياً: الصراعات الكبرى التي تمثل تحدياً للنظام الأمني العربي الأفريقي مثل الصومال ودارفور وشمال مالي تطرح أهمية التنسيق والبحث عن حلول عربية أفريقية لها دون تدخل أطراف خارجية. واحسب أن هذه التحديات الأمنية الكبرى تقضي بضرورة البحث عن نظام أمني عربي أفريقي مشترك للتدخل في مناطق التوتر والصراع بغية حفظ وصنع السلام.
ثالثاً: تغير طبيعة توازن القوى في مناطق التماس العربي الأفريقي ومثال ذلك منطقتي القرن الأفريقي وحوض النيل، وهو ما يعني ضرورة تأسيس الحوار العربي الأفريقي على قواعد ومعايير جديدة. وعلى سبيل المثال بينما شهدت الصياغة الجيواستراتيجية الجديدة للفضاء العربي الأفريقي تراجعاً للدورين المصري (بعد سقوط نظام مبارك) والسوداني (بعد انفصال الجنوب) وتفتيت الصومال بعد فرض الارادة الدولية عليه عام 2012 فإن أثيوبيا ودول شرق أفريقيا شهدت نهوضاً ملحوظاً ودعماً دولياً واضحاً، وهو ما يعني ضرورة اعادة التفاوض بشأن توزيع مياه النيل.
رابعاً: محاولة اسرائيل اختراق منظومة الأمن الجماعي الأفريقي من خلال محاولاتها الدعوية الالتحاق كعضو مراقب في الاتحاد الأفريقي، وعلى الرغم من أن المحاولات الاسرائيلية قد باءت بالفشل إلا أنها تحاول جاهدة من خلال وسطاء أفارقة أبرزهم نيجيريا وأثيوبيا وكينيا الفوز بعضوية الاتحاد الأفريقي في دورته القادمة. ومن الواضح كما أبرزت حادثة الهجوم الذي وقع في سبتمبر/أيلول الماضي على مركز وست جيت التجاري في نيروبي أن اسرائيل تمتلك نفوذاً قوياً في دول حوض النيل.
خامساً: التكالب الدولي الجديد على الموارد الأفريقية وظهور سياسات جديدة لاعادة انتاج الهيمنة الدولية على أفريقيا وفقاً لآليات وأدوات جديدة، فإنشاء القيادة الأفريقية (أفريكوم) عام 2008 ووجود معسكرات أمريكية في جيبوتي والنيجر بالاضافة إلى التدخل العسكري الفرنسي والغربي المباشر في الصراعات الأفريقية يمثل تهديداً مباشراً للأمن الجماعي العربي والأفريقي .كما أن محاولات الصين وبعض القوى الصاعدة الأخرى في النظام الدولي كسب النفوذ والسيطرة في أفريقيا تمثل هي الأخرى تحديات لمنظومة العلاقات العربية الأفريقية.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار طبيعة التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية التي تواجهها الشعوب العربية والأفريقية لوجدنا أن الاستجابة لروح مشروع النهضة الأفريقية كما أسس له رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي وطموحات المبادرة الجديدة للتنمية في أفريقيا (النيباد) عام 2001 تعني ضرورة الانحياز لخيار التعاون العربي والأفريقي وفقاً لمنظور الشراكة والمصالح المشتركة.
ما الذي حدث خطأ؟لقد كان المأمول في السبعينيات من القرن المنصرم اضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات العربية الأفريقية من خلال مؤتمر القاهرة عام 1977، وخلال هذه الفترة تحدث البعض عن "استراتيجية سلة الغذاء" حيث تساعد الدول الأفريقية الغنية بمواردها الطبيعية فى تحقيق الأمن الغذائي العربي في حين تساعد الدول العربية النفطية الغنية في توفير الدعم المالي والتنموي اللازم لنهضة أفريقيا.
ويمكن فهم الاتجاه الحماسي لدعم التعاون العربي الأفريقي خلال هذه المرحلة التأسيسية استنادا إلى عدة اعتبارات لعل من أبرزها: التوكيد المشترك على أهمية الاعتماد الجماعي على الذات لمواجهة تحديات التنمية في العالمين العربي والأفريقي، وقيام اسرائيل عام 1967 باحتلال أراضي أفريقية وهو ما جعل كثير من الدول الأفريقية تقطع علاقاتها معهاً في أعقاب حرب 1973. يقول الرئيس احمد سيكوتوري:" إن دعمنا للقضايا العربية ينبع من مسألة التضامن العربي الأفريقي التي كانت تشكل دائما ركيزة أساسية لسياسة غينيا . ولا يعتمد هذا الدعم على أي مكافآت مالية تدفع لنا من قبل العرب .
لقد وقفنا من قبل مع العرب لأننا اعتقدنا أنهم كانوا على حق ، وليس لأننا توقعنا منهم أي مكاسب مالية . ولا أدل على ذلك من قيام غينيا بقطع علاقاتها مع إسرائيل عام 1967 عندما بدأت الدولة الصهيونية عدوانها ضد العرب . فعلنا هذا على الفور ، دون التفكير في العواقب المترتبة على هذا الاجراء ،مثل توقع الحصول على مساعدة مالية من الدول العربية الغنية بالنفط . لقد قررنا قطع العلاقات مع إسرائيل حتى لو طلبت منا الدول العربية ذاتها عدم القيام بذلك. أود أن أقول لأولئك الذين يحاججون بأننا نتعاون مع العرب من أجل المال: إننا شعب متدين، يؤمن بالله ، ولدينا شعور عميق بالكرامة والمسؤولية . نحن لسنا انتهازيين ولا متسولين بغض النظر عن كوننا فقراء"
ومع ذلك فإن المتغير الأهم في العلاقة مع أفريقيا خلال حقبة السبعينيات من القرن الماضي هو الدعم المالي العربي والذي يتضح من تأسيس بعض المؤسسات التمويلية والتنموية مثل البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا عام 1974، والصناديق العربية للمساعدات المالية والفنية المقدمة للدول الأفريقية.
لقد أصدرت القمة الأفروعربية الأولى بالقاهرة أربعة وثائق مهمة هي:1. الاعلان السياسي والذي أكد على أهمية استناد التعاون على ميثاق كل من الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية، وهو ما يعني مساندة كفاح الشعب الفلسطيني ومواجهة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
2. برنامج عمل التعاون العربي الأفريقي ولا سيما في المستويات القطاعية المختلفة.
3. تنظيم وطريقة تحقيق التعاون العربي الأفريقي حيث تم الاتفاق على انشاء المجلس الوزاري المشترك والذي يعقد جلساته بشكل دوري كل 18 شهراً في حين يعقد مجلس رؤساء الدول اجتماعاته كل ثلاثة سنوات. بالاضافة إلى ذلك فقد تم تشكيل اللجنة الدائمة للتعاون العربي الأفريقي، وهي مؤلفة من 24 عضوا نصفهم من أفريقيا والنصف الآخر من العالم العربي. وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها كل ستة أشهر لمتابعة تنفيذ قرارات التعاون العربي الأفريقي.
4. قرار التعاون المالي والاقتصادي والذي ظل من الناحية الواقعية مجرد اعلان للنوايا من الجانب العربي بدعم الدول الأفريقية مالياً واقتصادياً.
ومع ذلك فقد باءت هذه الجهود بالفشل وضاعت على كل من العرب والأفارقة فرصة تاريخية لشراكة استراتيجية حقيقية. وربما يعزى ذلك لتغليب الاعتبارات السياسية وسيادة مفاهيم الابتزاز وعدم المساواة في الحوار التفاوضي بين طرفي العلاقة. وعلى سبيل المثال فقد كانت المساعدات العربية لأفريقيا مشروطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بمواقف الدول الأفريقية الداعمة للقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
أضف إلى ذلك فإن قيام مصر بتوقيع اتفاقيات كامب ديفيد عام 1979 وتجميد عضويتها في الجامعة العربية قد أدى إلى غياب دورها المحوري الداعم لمسيرة العلاقات العربية الأفريقية. ومن جهة ثالثة مثلت قضية الصحراء الغربية بين المغرب والجزائر ومغامرات ليبيا العسكرية في تشاد حجر عثرة أخرى أمام دعم وتنفيذ خطة عمل التعاون العربي الأفريقي التي أقرتها القمة الأفروعربية الأولى.
ومن الواضح أن بداية الألفية الجديدة والتحولات الكبرى التي شهدتها منظمة الوحدة الأفريقية وتحولها إلى الاتحاد الأفريقي عام 2002 قد دفعت جميعها إلى اعادة الاعتبار مرة أخرى للتعاون العربي الأفريقي.
ربما ساعدت شخصية العقيد الليبي الراحل معمر القذافي وتطلعه إلى ممارسة دور قيادي في أفريقيا إلى اتعقاد القمة الأفروعربية الثانية في سرت عام 2010. وقد أصدرت هذه القمة وثيقتين هامتين: الأولى بعنوان استراتيجية الشراكة العربية الأفريقية وهي تتألف من أربعة مجالات هي السلم والأمن، حوافز الاستثمار والتبادل التجاري، والأمن الغذائي والزراعي، والتعاون الثقافي والاجتماعي. وقد تم توضيح أبعاد هذه الاستراتيجية في الوثيقة الثانية التي أصدرها المؤتمر بعنوان " خطة العمل العربي الأفريقي المشترك 2011-2016" وهي تتضمن ثلاثين صفحة حول اجراءات محددة لتعزيز التعاون العربي الأفريقي.
الأفروعربية والعبور للمستقبل:ان القراءة الواعية لتحديات العلاقات العربية الأفريقية تظهر أهمية التوقف عند اعتبارات ثلاثة أساسية يترتب عليها امكانية تأسيس شراكة عربية أفريقية حقيقية، والعبور إلى المستقبل بحيث يصبح القرن الحادي والعشرين قرناً عربياً أفريقيا بامتياز.
العامل الأول: ويتمثل في المقايضة السياسية حيث بنيت العلاقة في معظم فتراتها بين العرب والافارقة على اساس أن مقابل الدعم المالي العربي هو توقع مساندة الأفارقة للقضايا العربية في المحافل الدولية. ولا شك أن هذا الثمن السياسي لا يعبر عن ارادة حقيقية من الطرفين لاقامة شراكة استراتيجية تقوم على أساس التكافؤ والمساواة.
العامل الثاني: فإنه يتمثل في غياب التوازن أو ان شئت الدقة فقل المساواة في منظومة العلاقات العربية الأفريقية، وربما دفع ذلك إلى قيام الدول العربية بتبني المنظور الثنائي في علاقتها مع أفريقيا لضمان تحقيق مصالحها الوطنية بما يعني الابتعاد عن الاطار المؤسسي للتعاون والذي انتجته القمة الأفروعربية الأولى عام 1977.
العامل الثالث: يتمثل في تدخل الأطراف الدولية لتعطيل مسيرة التعاون العربي الأفريقي، فبالاضافة إلى القوى الاستعمارية التقليدية مثل بريطاميا وفرنسا، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة ما بعد الحادي من سبتمبر لتحمل شعار محاربة الارهاب في أفريقيا، وهو ما يعني في جوهره تفجير مناطق وبؤر التوتر القلقة في العالمين العربي والأفريقي.
كما أن القوى الصاعدة مثل الصين والقوى الاقليمية التقليدية مثل تركيا واسرائيل وإيران تحاول من خلال سياساتها الأفريقية وأدوات قوتها الناعمة خلق مناطق نفوذ لها في المحيط الاستراتيجي العربي في أفريقيا، وهو ما يمثل تحدياً مهماً أمام تنفيذ خطة التعاون العربي الأفريقي، ويمكن في هذا السياق أن نشير الى خطورة الدور الصيني وتوفيره للدعم والتمويل اللازم في منطقة حوض النيل بما يتعارض والمصالح المائية المصرية.
كما أن وجود دولة مثل ايران قد يعني تمزيق الكتلة الاسلامية في أفريقيا من خلال اثارة النزعات الدينية الطائفية. والملاحظ أن البعد الاسلامي مثل دائماً أحد محفزات التعاون العربي الأفريقي.يقول على مزروعي:" إن تاريخ العرب في أفريقيا ينطوي على عدد من التناقضات. فقد كان العرب فاتحين ومحررين على حد سواء ، كما شاركوا في تجارة الرقيق وبشروا بأفكار جديدة. كما حمل العرب معهم الاسلام والتجارة. وفي واقع الأمر فقد ارتبط الاسلام بحركة التجارة في معظم فترات التاريخ الحديث لأفريقيا شمال نهر الزامبيزي. ولايخفى أن قوافل التجار المسلمين في شمال وغرب أفريقيا ترجع الى مئات السنين. وفي شرق أفريقيا جاء التجار عبر قرون عديدة أيضا من خليج عمان وجنوب شبه الجزيرة العربية حيث قاموا بدور بارز في نشر الثقافة والمعرفة. وعليه لم يكن انتشار الاسلام في أفريقيا نتيجة عمل تبشيري منظم بقدر ما كان نتاج حركة التجارة والفتح". ومع ذلك فقد أضحى العامل الاسلامي اليوم دافعا للانقسام والتناحر كما تعبر عن ذلك خبرة بوكوحرام في نيجيريا والشباب المجاهدين في الصومال والسلفية الجهادية في شمال مالي.
ما العمل إذاً؟
أحسب أن قمة الكويت الأفروعربية الثالثة يمكن أن تمثل نقطة تحول فارقة من أجل تحقيق الهدف الذي يجسده عنوانها: شركاء في التنمية والاستثمار. فالشراكة العربية الأفريقية يمكن لها أن تقوم على أسس ومحاور جديدة تعكس المصالح المشتركة للشعوب العربية والأفريقية وذلك في المجالات الستة الآتية: السلام والأمن، والأمن الغذائي، والتجارة والاستثمار،وتنمية القطاع الخاص،و تنمية البنية الأساسية، وتعزيز دور المرأة في التنمية. على أن تحقيق هذه الانطلاقة يرتبط بتبني ثلاثة مداخل أساسية:
أولها المدخل الثقافي والاعلامي بهدف تجاوز الحساسيات التاريخية والتي تجسدها الصور الذهنية والأنماط الجامدة السلبية السائدة بين العرب والأفارقة. لابد من تجاوز اشكالية الهوية التي وقفت حائلاً أمام الشراكة المتساوية بين الطرفين، فمناطق مثل دارفور وشمال مالي، وموريتانيا تعكس انقساماً في الهوية بين العرب والأفارقة والذي كرسته المواريث الاستعمارية والسياسات الوطنية الخاطئة. اننا بحاجة إلى تبني منظور جديد يركز على أهمية الاستفادة من الخبرات المشتركة للشعوب العربية والأفريقية على قدم المساواة. فالأفروعربية الثقافية التي جسدتها الهجرات العربية الأفريقية وعلاقات الدم والزواج والمصاهرة تمثل مدخلاً مهماً لمحو آثار الماضي والانطلاق نحو المستقبل.
أما المدخل الثاني فإنه اقتصادي تنموي يركز على منظور المنافع المشتركة، وهو ما يشير إلى اقامة شراكة حقيقية في اطار تنمية دول الجنوب والاعتماد الجماعي على الذات. ولعل مشروع ربط اليمن بجيبوتي عن طريق اقامة جسر يربط بين جانبي مضيق باب المندب يمثل خطوة مهمة في اعادة اللحمة العضوية بين شبه الجزيرة العربية والساحل الشرقي لأفريقيا. ومن المفيد الاشارة إلى أهمية هذا المنظور التنموي في تجاوز كثير من الأزمات التي تعترض العلاقات العربية الأفريقية مثل الصومال والسودان ومسالة مياه النيل.
ويشير المدخل الثالث إلى الجانب الأمني .فثمة تهديدات مشتركة نابعة من الصراعات المسلحة وعمليات التهريب عبر الحدود وقضايا التطرف الديني وهو ما يفرض ضرورة التعاون الأمني بين العرب والأفارقة لمواجهة هذه التحديات الخطيرة. ولعل نجاح أفريقيا في صياغة منظور أمني جديد منذ عام 2002 يمثل خطوة مهمة للاستفادة منها في اصلاح منظومة الأمن الجماعي القائمة في النظام الاقليمي العربي.
وأيا كان الأمر فإن نجاح قمة الكويت في تأسيس شراكة استراتيجية جديدة بين العرب والأفارقة رهن بمدى نجاحها في عدم تسييس العلاقة بين الطرفين وتدشين حوار استراتيجي جديد يناقش كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك على قدم المساواة. ولعل ذلك كله يفرض علينا ضرورة تبني شعار " التوجه جنوباً" نحو أفريقيا للانطلاق معاً نحو آفاق جديدة للنهضة والرقي. فهل نتعلم من أخطاء الماضي ونواجه تحديات الحاضر لتحقيق حلم الأفروعربية مرة أخرى؟
المصادر
[1] حمدي عبد الرحمن، العلاقات العربية الإفريقية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، مجلة قضايا استراتيجية، العدد (2)، يونيو 2000م، (دمشق: المركز العربي للدراسات الاستراتيجية)
[2] حمدي عبدالرحمن ، العرب وإفريقيا في زمن متحول، القاهرة: دار مصر المحروسة للنشر والتوزيع، 2009.
[3] عبد الملك عودة، نظرة استراتيجية مستقبلية للعلاقات العربية الإفريقية، في :العرب وإفريقيا.. فيما بعد الحرب الباردة ،القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مركز دراسات الدول النامية ،2000.
[4] محمود خيري عيسى، العلاقات العربية الإفريقية: دراسة تحليلية في أبعادها المختلفة، القاهرة: جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات العربية،, 1978 .
[5] Ali A. Mazrui, Africa's International Relations: The Diplomacy of Dependency and Change (London and Boulder, Colorado; Heinemann and Westview Press, 1977 , pp. 130—55.
[6] Anthony Sylvester, Arabs and Africans: Cooperation for Development (London: The Bodley Head, 1981, p. 201
[7] Oluwatoki, Jamiu. 2003. "Afro-Arab Relations: Historical Roots and Contemporary Connections". Nigerian Journal of International Affairs. 29, no. 1/2: 265-281.
[8] Prah, Kwesi Kwaa. 2006. "Towards a Strategic Geopolitic Vision of Afro-Arab Relations". African Renaissance. 3, no. 5: 127-135.
Published on November 11, 2013 10:47
إلياس بلكا's Blog
- إلياس بلكا's profile
- 50 followers
إلياس بلكا isn't a Goodreads Author
(yet),
but they
do have a blog,
so here are some recent posts imported from
their feed.



