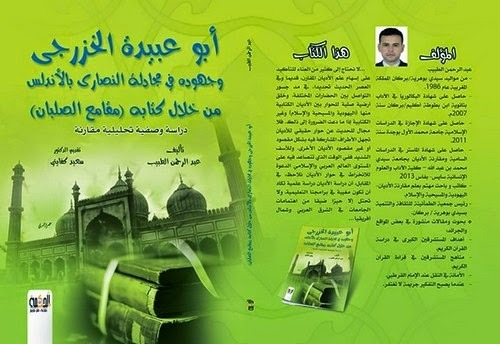إلياس بلكا's Blog, page 8
July 3, 2014
تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام: توقــــــع أتمنى ألاّ يتحقق.
توقــــــع أتمنى ألاّ يتحقق:
تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام يتوسع في العراق وفي سوريا، وربما يفكر قريبا في مناوشة الأردن والسعودية، وسبق أن استعدى تركيا بالقبض على مواطنيها.. بل أعلن الخلافة الإسلامية أيضا، وطالب الجميع بالانضواء تحت رايته.
سيتوسّع التنظيم على الأرض لبعض الوقت، لكنه توسع مؤقت، لأنه مع كل يوم يمرّ سيرتكب أخطاء، فهو سيعامل الجميع بمنطق إما معي وتحت إمرتي وبحسب فهمي للأمور، وإما أنت عدوّ لي.. في النهاية سيستدعي التنظيم عداوة الجميع: الدول كتركيا والسعودية وإيران والأردن.. والجماعات كالأكراد والشيعة.. وسيستعدي عليه أيضا الأكثرية الساحقة من أهل السنة خاصة في العراق وسوريا.. لذلك سيدخل التنظيم في معارك مع الجميع، لذلك سيتعاون عليه الجميع.. وفي ظرف لا يتجاوز سنة واحدة ابتداء من هذه الأيام.. سينهار التنظيم، ويتفرق أعضاؤه بين قتيل ومسجون وهارب.. لكن هذا لن يحدث قبل أن يُسبب للجميع أضرارا بالغة بسبب قوة التنظيم، لكن أكبر المتضررين سيكونون هم أهل السنة.. سيتضرر أهل السنة كثيرا من مغامرة الخلافة هذه، وسيخسرون مكاسب مهمة كانت تحققت أو بصدد التحقق في العراق وسوريا بالخصوص.. كما سيخسرون دماء غزيرة عزيزة لأن التنظيم سيثبت أنه الأنكى في قتل أهل السنة والأقدر على ذبحهم.. وسيسهل عليه ذلك لأنه سيعتبرهم كفارا.
هذا هو السيناريو الذي أتمنى ألا يتحقق، لكن غالب ظني أنه الذي سيكون.
أما السيناريو الآخر فهو دخول التنظيم في مفاوضات وتوافقات مع شركائه من أهل السنة، وقبوله لموقف السنّة العراقيين الذين يفرقون بين الحكومة الحالية وعامة الشيعة من أفراد الشعب، وقبوله أيضا لاختيارات السوريين.. بمعنى أن يتعاون التنظيم مع بيئته ومحيطه، ويقبل بأن يكون طرفا من الأطراف، ولا يحاول إخضاع الآخرين ولا إلغاء دورهم ووجودهم..
ولا علاقة لهذا بموضوع مظلومية أهل السنة بالعراق وحقهم في أن يشاركوا في إدارة بلدهم.. فأنا أعترف بهذا وأدعمه.
والله تعالى أعلم وأحكم.
تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام يتوسع في العراق وفي سوريا، وربما يفكر قريبا في مناوشة الأردن والسعودية، وسبق أن استعدى تركيا بالقبض على مواطنيها.. بل أعلن الخلافة الإسلامية أيضا، وطالب الجميع بالانضواء تحت رايته.
سيتوسّع التنظيم على الأرض لبعض الوقت، لكنه توسع مؤقت، لأنه مع كل يوم يمرّ سيرتكب أخطاء، فهو سيعامل الجميع بمنطق إما معي وتحت إمرتي وبحسب فهمي للأمور، وإما أنت عدوّ لي.. في النهاية سيستدعي التنظيم عداوة الجميع: الدول كتركيا والسعودية وإيران والأردن.. والجماعات كالأكراد والشيعة.. وسيستعدي عليه أيضا الأكثرية الساحقة من أهل السنة خاصة في العراق وسوريا.. لذلك سيدخل التنظيم في معارك مع الجميع، لذلك سيتعاون عليه الجميع.. وفي ظرف لا يتجاوز سنة واحدة ابتداء من هذه الأيام.. سينهار التنظيم، ويتفرق أعضاؤه بين قتيل ومسجون وهارب.. لكن هذا لن يحدث قبل أن يُسبب للجميع أضرارا بالغة بسبب قوة التنظيم، لكن أكبر المتضررين سيكونون هم أهل السنة.. سيتضرر أهل السنة كثيرا من مغامرة الخلافة هذه، وسيخسرون مكاسب مهمة كانت تحققت أو بصدد التحقق في العراق وسوريا بالخصوص.. كما سيخسرون دماء غزيرة عزيزة لأن التنظيم سيثبت أنه الأنكى في قتل أهل السنة والأقدر على ذبحهم.. وسيسهل عليه ذلك لأنه سيعتبرهم كفارا.
هذا هو السيناريو الذي أتمنى ألا يتحقق، لكن غالب ظني أنه الذي سيكون.
أما السيناريو الآخر فهو دخول التنظيم في مفاوضات وتوافقات مع شركائه من أهل السنة، وقبوله لموقف السنّة العراقيين الذين يفرقون بين الحكومة الحالية وعامة الشيعة من أفراد الشعب، وقبوله أيضا لاختيارات السوريين.. بمعنى أن يتعاون التنظيم مع بيئته ومحيطه، ويقبل بأن يكون طرفا من الأطراف، ولا يحاول إخضاع الآخرين ولا إلغاء دورهم ووجودهم..
ولا علاقة لهذا بموضوع مظلومية أهل السنة بالعراق وحقهم في أن يشاركوا في إدارة بلدهم.. فأنا أعترف بهذا وأدعمه.
والله تعالى أعلم وأحكم.
Published on July 03, 2014 16:12
May 10, 2014
حرية المعتقد والتعبير: الضرورة والمحاذير.
حرية المعتقد والتعبير: الضرورة والمحاذير.
إلياس بلكا
الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، لذلك فهو يعيش بالضرورة في جماعة. هذه الفكرة الأولية والبسيطة هي أساس ما يسمى بـ"نظريات العقد الاجتماعي" التي تتفق جميعها على أن الناس تعاقدوا على تأسيس نظام اجتماعي وسياسي محدد، غالبا ما تكون على رأسه مؤسسة الدولة.. وعلى أن الإنسان مضطر في هذا السبيل للتنازل عن جزء من حريته وأنانيته.. ثم تختلف التفاصيل بين مفكري السياسة المسلمين والغربيين الذين تعرضوا لهذا الموضوع، ومنهم: أبو المعالي الجويني وأبو حامد الغزالي وابن الأزرق وابن تيمية وابن خلدون.. ومنهم أيضا: جان جاك روسو وهوبز وجون لوك..لذلك حين يُطرح موضوع حرية التعبير والمعتقد فإنه يطرح في إطار صلته بالجماعة البشرية التي نسميها "المجتمع". ولا يمكن طرحها من المنظور الفردي الضيق.. بمعنى أن الموضوع لا يتعلق بالأفراد فقط، بل بالجماعات أيضا.. لذلك قالوا: إن حريتك تنتهي عند حدود حرية الآخرين. فلا وجود لحرية مطلقة أبدا.. الحرية المطلقة حلم أو وهم ليس إلاّ.
لكن الفكر الأوربي منذ عصر الإنسانوية، ثم عصر الأنوار، بدأ يحتفل بقيمة الفرد على حساب قيم الجماعة.. ثم مع التطور السياسي والعلمي والاقتصادي وغيره.. ومع ظهور البروتستانتية أيضا.. تبلور هذا التفكير في عقيدة "حقوق الإنسان" (لاحظ أنه لا أحد يتحدث عن حقوق الشعوب مثلا.. فالتأكيد فقط على الإنسان/ الفرد).من هذه الحقوق: الحق في حرية التعبير والمعتقد. ولعلّه اليوم لا يجادل أحد في هذا الحق من الناحية المبدئية، والقرآن الكريم نفسه يعلنها صريحة: (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)، ويقول: (لا إكراه في الدين). وحكى هذا الكتاب العظيم عقائد شركية كثيرة، أوْردها ثم ردّها..
لكن السؤال يتعلق دائما بالمدى: ما هو مدى ممارسة هذا الحق؟ هل توجد حدود لحرية التعبير والاعتقاد؟
الحقيقة أننا إذا تجاوزنا النقاش النظري في الجواب عن هذا السؤال، فإننا نكتشف أن جميع البلدان والحضارات اليوم تضع حدودا على هذا الحق، ليس نظريا بل من الناحية العملية. دعْ عنك الشعارات والكلام الإعلامي، وانظر إلى الممارسة. فماذا نكتشف؟توجد في القوانين الجنائية الأوربية فصول وأحكام تتعلق بالإساءة للغير، سواء بالفعل أم بالقول، وسواء كان هذا الغير أفرادا أو مؤسسات.. لذلك نسمع بين الفينة والأخرى أخبارا عن قضايا في المحاكم أحد أطرافها الصحافة ووسائل الإعلام.. فلا توجد مثلا صحافة لها حرية مطلقة في أن تكتب ما تشاء.
وفي كثير من الدول الأوربية والأمريكية تستطيع أن تشتم الأديان والأنبياء وكل المقدسات بدعوى حرية التعبير، لكنك إذا انتقدت "إسرائيل" وممارساتها العدوانية فإن هناك قانونا جاهزا قد يدخلك إلى السجن من أبوابه الواسعة، يسمى: قانون معاداة السامية.
وإذا كنتَ مهتما بالتاريخ الأوربي الحديث، واقتنعت مثلا بأن الهولوكست أسطورة وأنه لم توجد محرقة لليهود في الحرب العالمية الثانية.. فإن مصيرك هو السجن أيضا، كما حدث للمؤرخ البريطاني ديفيد إرفينج.. حتى لو كانت عندك "أدلة تاريخية"، بمعنى حتى لو كان الأمر تعبيرا عن قناعة "علمية تاريخية". لست أناقش هنا موضوع الهولوكست: هل هو أسطورة صرفة، أم حقيقة تاريخية بالغت الصهيونية في تصويرها وفي تعديد ضحاياها.. لكن المقصود أنه في هذا الموضوع عليك أن تؤمن وتُسلم، وليس من حقك أن تعلن رأيا آخر، بل قد يكون مصيرك إذا فعلت هو السجن والإدانة.يمكن أن نمضي في تعداد الأمثلة إلى ما لا نهاية، لكنني أقول بمناسبة موافقة المغرب هذا الشهر على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حرية الاعتقاد والتدين:
إن لهذا الانضمام إيجابياته وسلبياته. فهو قد يوسّع من دائرة حرية التعبير في مجتمعنا، وهذا مهم لأن الحرية شرط الإبداع والتنمية..لكنه من جهة أخرى قد يدفع البلد إلى تقديم تنازلات تتعلق بهويته واختياراته الدينية والفكرية والهوياتية.. كما قد يستغله بعض الناس استغلالا مقصودا ومتعمدا بإثارة معارك جانبية وهامشية لأغراض إشغال المجتمع عن قضاياه الكبرى والمصيرية، أو لأغراض الشهرة وحب الظهور، أو لأجل إحداث انقسامات جديدة في البلد على أسس أخرى (مثلا مغربي مسلم/ مغربي غير مسلم..)، إضافة إلى الانشقاقات القائمة أصلا.
ما الحلّ؟ الحل في اكتشاف نموذج جديد للحريات العامة، نموذج من داخل منظومتنا الفكرية وفي نفس الوقت يكون مناسبا للعصر، ثم يعمل تعاون عربي وإسلامي واسع على تطبيق هذا النموذج داخليا وعلى الدفاع عنه وترويجه خارجيا.. لأنه لا يمكن لدولة منفردة مهما كان حجمها أن تواجه الهيمنة الغربية والدولية في قضايا حقوق الإنسان، ولا في قضايا السياسة الدولية والاقتصادية. إن الغرب يفرض علينا إرادته لأنه يستفْـرد بنا واحدا بعدَ واحد، فهو دائما ما يواجهنا مجتمِعا بينما نواجهه نحن فرادى.نشر جزء من هذا المقال بموقع هسبريس:http://www.hespress.com/orbites/198481.html
إلياس بلكا
الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، لذلك فهو يعيش بالضرورة في جماعة. هذه الفكرة الأولية والبسيطة هي أساس ما يسمى بـ"نظريات العقد الاجتماعي" التي تتفق جميعها على أن الناس تعاقدوا على تأسيس نظام اجتماعي وسياسي محدد، غالبا ما تكون على رأسه مؤسسة الدولة.. وعلى أن الإنسان مضطر في هذا السبيل للتنازل عن جزء من حريته وأنانيته.. ثم تختلف التفاصيل بين مفكري السياسة المسلمين والغربيين الذين تعرضوا لهذا الموضوع، ومنهم: أبو المعالي الجويني وأبو حامد الغزالي وابن الأزرق وابن تيمية وابن خلدون.. ومنهم أيضا: جان جاك روسو وهوبز وجون لوك..لذلك حين يُطرح موضوع حرية التعبير والمعتقد فإنه يطرح في إطار صلته بالجماعة البشرية التي نسميها "المجتمع". ولا يمكن طرحها من المنظور الفردي الضيق.. بمعنى أن الموضوع لا يتعلق بالأفراد فقط، بل بالجماعات أيضا.. لذلك قالوا: إن حريتك تنتهي عند حدود حرية الآخرين. فلا وجود لحرية مطلقة أبدا.. الحرية المطلقة حلم أو وهم ليس إلاّ.
لكن الفكر الأوربي منذ عصر الإنسانوية، ثم عصر الأنوار، بدأ يحتفل بقيمة الفرد على حساب قيم الجماعة.. ثم مع التطور السياسي والعلمي والاقتصادي وغيره.. ومع ظهور البروتستانتية أيضا.. تبلور هذا التفكير في عقيدة "حقوق الإنسان" (لاحظ أنه لا أحد يتحدث عن حقوق الشعوب مثلا.. فالتأكيد فقط على الإنسان/ الفرد).من هذه الحقوق: الحق في حرية التعبير والمعتقد. ولعلّه اليوم لا يجادل أحد في هذا الحق من الناحية المبدئية، والقرآن الكريم نفسه يعلنها صريحة: (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)، ويقول: (لا إكراه في الدين). وحكى هذا الكتاب العظيم عقائد شركية كثيرة، أوْردها ثم ردّها..
لكن السؤال يتعلق دائما بالمدى: ما هو مدى ممارسة هذا الحق؟ هل توجد حدود لحرية التعبير والاعتقاد؟
الحقيقة أننا إذا تجاوزنا النقاش النظري في الجواب عن هذا السؤال، فإننا نكتشف أن جميع البلدان والحضارات اليوم تضع حدودا على هذا الحق، ليس نظريا بل من الناحية العملية. دعْ عنك الشعارات والكلام الإعلامي، وانظر إلى الممارسة. فماذا نكتشف؟توجد في القوانين الجنائية الأوربية فصول وأحكام تتعلق بالإساءة للغير، سواء بالفعل أم بالقول، وسواء كان هذا الغير أفرادا أو مؤسسات.. لذلك نسمع بين الفينة والأخرى أخبارا عن قضايا في المحاكم أحد أطرافها الصحافة ووسائل الإعلام.. فلا توجد مثلا صحافة لها حرية مطلقة في أن تكتب ما تشاء.
وفي كثير من الدول الأوربية والأمريكية تستطيع أن تشتم الأديان والأنبياء وكل المقدسات بدعوى حرية التعبير، لكنك إذا انتقدت "إسرائيل" وممارساتها العدوانية فإن هناك قانونا جاهزا قد يدخلك إلى السجن من أبوابه الواسعة، يسمى: قانون معاداة السامية.
وإذا كنتَ مهتما بالتاريخ الأوربي الحديث، واقتنعت مثلا بأن الهولوكست أسطورة وأنه لم توجد محرقة لليهود في الحرب العالمية الثانية.. فإن مصيرك هو السجن أيضا، كما حدث للمؤرخ البريطاني ديفيد إرفينج.. حتى لو كانت عندك "أدلة تاريخية"، بمعنى حتى لو كان الأمر تعبيرا عن قناعة "علمية تاريخية". لست أناقش هنا موضوع الهولوكست: هل هو أسطورة صرفة، أم حقيقة تاريخية بالغت الصهيونية في تصويرها وفي تعديد ضحاياها.. لكن المقصود أنه في هذا الموضوع عليك أن تؤمن وتُسلم، وليس من حقك أن تعلن رأيا آخر، بل قد يكون مصيرك إذا فعلت هو السجن والإدانة.يمكن أن نمضي في تعداد الأمثلة إلى ما لا نهاية، لكنني أقول بمناسبة موافقة المغرب هذا الشهر على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حرية الاعتقاد والتدين:
إن لهذا الانضمام إيجابياته وسلبياته. فهو قد يوسّع من دائرة حرية التعبير في مجتمعنا، وهذا مهم لأن الحرية شرط الإبداع والتنمية..لكنه من جهة أخرى قد يدفع البلد إلى تقديم تنازلات تتعلق بهويته واختياراته الدينية والفكرية والهوياتية.. كما قد يستغله بعض الناس استغلالا مقصودا ومتعمدا بإثارة معارك جانبية وهامشية لأغراض إشغال المجتمع عن قضاياه الكبرى والمصيرية، أو لأغراض الشهرة وحب الظهور، أو لأجل إحداث انقسامات جديدة في البلد على أسس أخرى (مثلا مغربي مسلم/ مغربي غير مسلم..)، إضافة إلى الانشقاقات القائمة أصلا.
ما الحلّ؟ الحل في اكتشاف نموذج جديد للحريات العامة، نموذج من داخل منظومتنا الفكرية وفي نفس الوقت يكون مناسبا للعصر، ثم يعمل تعاون عربي وإسلامي واسع على تطبيق هذا النموذج داخليا وعلى الدفاع عنه وترويجه خارجيا.. لأنه لا يمكن لدولة منفردة مهما كان حجمها أن تواجه الهيمنة الغربية والدولية في قضايا حقوق الإنسان، ولا في قضايا السياسة الدولية والاقتصادية. إن الغرب يفرض علينا إرادته لأنه يستفْـرد بنا واحدا بعدَ واحد، فهو دائما ما يواجهنا مجتمِعا بينما نواجهه نحن فرادى.نشر جزء من هذا المقال بموقع هسبريس:http://www.hespress.com/orbites/198481.html
Published on May 10, 2014 13:37
May 3, 2014
إشكالية الهوية والتعدد اللغوي بالمغرب الكبير: نموذج من المغرب الأقصى.
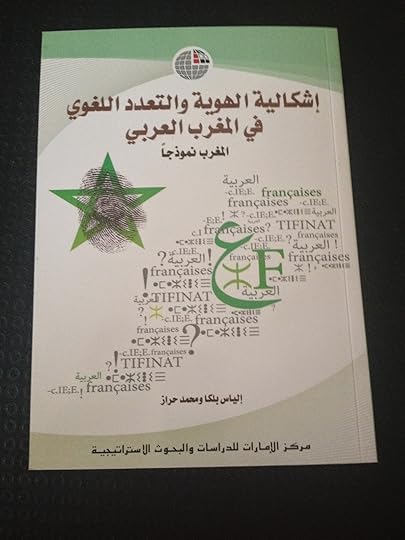
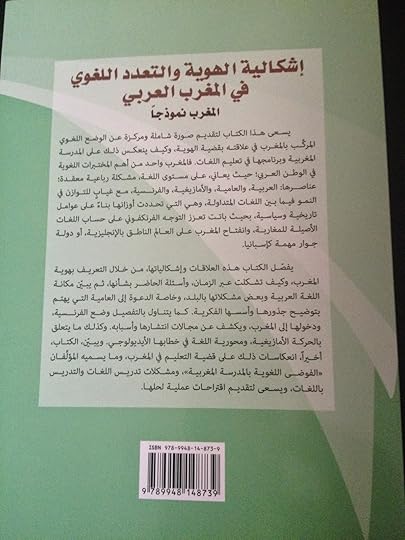
إشكالية الهوية والتعدد اللغوي بالمغرب
إلياس بلكا
وموضوع هذا الكتاب هو العلاقة بين الهوية واللغة في المغرب الكبير، وآثار ذلك على التربية والتعليم، حيث إن المدرسة هي المحضن الرئيس لأي محاولة نهضوية حقيقية. ولما كان التعليم يتأثر بنظرة المجتمع إلى نفسه، فقد أصبحت قضية الهوية لا تنفك عن التعليم ومشكلاته، خاصة أن اللغة مكوّن رئيس في تشكيل هوية الشعوب.
تتكوّن التركيبة السكانية للمغرب الكبير أساسا من العرب والأمازيغ الذين تمازجوا وتعايشوا، مع احتفاظ جزء مهم من المنطقة بلهجاتها وعاداتها الأمازيغية الخاصة. كما عرف المغرب الكبير الاستعمار الفرنسي الذي مارس سياسات اقتصادية وسياسية وإدارية ولغوية متقاربة.
هذا الوضع الجغرافي والتاريخي الخاص فرض على المنطقة ما يعرف بـ: مشكلة الهوية. ولما كانت علاقة الثقافات المحلية للمغاربيين بالثقافة الفرنسية في قلب هذه المشكلة.. فقد صار لقضية الهوية خصوصية أخرى، وهي أنها تـُطرح في إطار لغوي، بحيث لا يمكن الولوج إلى فهم مسألة هوية المنطقة ودراسة أصولها وآثارها.. دون التوقف عند قضية مكانة اللغة الفرنسية بها.
وتتفاوت دول المغرب الكبير في درجة الصلة بين الهوية واللغة، لكنه تفاوت في الدرجة لا في طبيعة المشكلة.
وقد اخترنا حصر الدراسة في المغرب لأنه المختبر اللغوي المثالي للمغرب الكبير كله، وواحد من أهم المختبرات اللغوية على مستوى الوطن العربي، فهو أكبر بلد أمازيغي في العالم وتنشط به الحركة الأمازيغية الحديثة التي أعادت طرح سؤال الهوية، وفيه أيضا أقلية تعرف اللغة الإسبانية.. لذلك فوضعه اللغوي هو الأكثر تعقيدا والأصعب في الدراسة من جميع الدول المغاربية الأخرى، لدرجة يمكن وصفه بـ"الفوضى اللغوية".
لذلك إذا نجح المغرب في عقد صلح الهوية واللغة –خاصة على مستوى المدرسة-، فمن باب أولى أن ينجح غيره من البلاد المغاربية والعربية.
لذلك خصصنا الفصل الأول لقضية الهوية، مع تركيز خاص على هوية المغرب الأقصى ومكوناتها وخصوصياتها.. كما خصصنا الفصل الرابع لسياسة فرض اللغة الفرنسية، والتي تسمى بالفرنكفونية، فعرفنا بهذه السياسة وبأساليبها وآثارها.. وبالوظائف التي تقوم بها هذه اللغة في المجتمع المغربي.
وبالرغم من محاربة الاستعمار الفرنسي للعربية، ومن تعثر سياسة التعريب في التعليم المغربي بعد الاستقلال، ومن سياسة الفرنكفونية اليوم.. فإنها ما زالت قادرة على أداء وظائفها الحضارية الثلاث: الوظيفة العقدية، والوحدوية، ثم الرسمية في الإدارة والإعلام.. وفي كل مؤسسات الدولة.. وهذا لا ينفي أن الفصحى بالمغرب تمر بأزمة حقيقية جراء احتكار اللغة الفرنسية خاصة لمختلف المجالات الحيوية في التعليم والإدارة والمؤسسات المالية والإعلام، وهذا ما تسبب في ضعف أدائها الوظيفي في الحياة العامة. لذلك أوردنا بعض عناصر خطة وطنية فاعلة للسياسة اللغوية للنهوض العلمي والحضاري بالعربية.. هذا وغيره كان موضوع الفصل الثاني.
وقد زاد اقتراح العامية الدارجة باعتبارها بديلا للعربية الفصحى في إضفاء تعقيد آخر على المشكلة. لذلك عقدنا الفصل الثالث لهذا الموضوع. إذ نشأت دعوة لاستعمال العامية في جميع المجالات، ويحاول أصحابها التنظير لها والتأصيل اللساني لاستخدامها، ويديرون صراعا لغويا عبر وضع اللغة العربية وحدها في جانب، ووضع الفرنسية والعامية والأمازيغية مجتمعة في جانب مقابل.
أما الفصل الخامس فيتعلق بالقضية الأمازيغية، فقد طرأ طارئ حديث جدا على الساحة المغاربية، وهو تبلور حركة سياسية وثقافية جعلت من الأمازيغية محور نشاطها وأساس مطالبها. هذه الحركة تحاول بناء نوع من "القومية الأمازيغية".. نوع غير متضح الملامح إلى حدّ الآن، لكن المؤكد أن اللغة الأمازيغية تشكل أساسه الأكبر، بل روحه حقا.
ولذلك نفهم لماذا كان شعار "اللغة الأمازيغية" هو السائد لدى هذا التيار الفكري والسياسي منذ نشأته إلى اليوم، حتى صار المدخل الرئيس "للهوية الأمازيغية" هو موضوع اللغة الأمازيغية.. وبهذا انصبت الجهود على معيرة اللهجات الأمازيغية ومحاولة بناء لغة موحدة، ثم السعي إلى تدريسها بالمدارس العمومية ونشرها بالتدريج باعتبارها لغة وطنية أو رسمية.. لذلك فالمسألة الأمازيغية تحتاج من الجميع إلى وقفة هادئة للتأمل والمراجعة.
أما الفصل الأخير فكان عن إشكالية لغة التدريس في المدرسة المغربية، اقترحنا فيه نموذجا محددا يتمثل في التعريب المدعوم بالتعدد اللغوي، مما يعين على وضع أسس متينة لاستقرار لساني متكامل، تحتل فيه العربية الفصحى موقعها المناسب، وتكون فيه اللغات الأمازيغية، أو اللغة الواحدة الممعيرة، لغات وطنية تُدرس وتُطور.. وتكون فيه أيضا اللغات الأجنبية لغات للدراسة لا للتدريس، مع ضمان هامش مهم من التعبير والتواصل الشفهي باللهجات العامية، في إطار متوازن ضمن سياسة لغوية وطنية فاعلة.
إن غاية هذه الدراسة هي المساهمة في حلّ مشكلة الهوية في صلتها بظاهرة الصراع اللغوي في المغرب، ووضع معالم سياسة لغوية رشيدة لا تمزّق النسيج الاجتماعي المغربي الذي تكوّن عبر قرون، كما لا تكون سببا في الفشل المدرسي واللغوي بكثرة اللغات وتصادمها..
Published on May 03, 2014 14:29
إشكالية الهوية والتعدد اللغوي بالمغرب.
إشكالية الهوية والتعدد اللغوي بالمغرب
إلياس بلكا
موضوع اللغة وتعلمها، سواء كانت لغة الأم، أو لغة وطنية أخرى، أو لغة أجنبية.. من الموضوعات المهمة التي لم يوليها الفكر الإسلامي الحديث ما تستحقه من جهد وبحوث ودراسات.. لذلك اشتغلت مع الدكتور محمد حراز –وهو أستاذ جامعي متخصص في مهن التربية والتكوين- على تأليف مشترك في الموضوع، فوضعنا – بحمد الله- كتابا بعنوان: "إشكالية الهوية والتعدد اللغوي بالمغرب العربي. المغرب نموذجا". وقد صدر هذا الكتاب في هذا الأسبوع عن "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية"، ومقره أبو ظبي.
وموضوع هذا الكتاب هو العلاقة بين الهوية واللغة في المغرب الكبير، وآثار ذلك على التربية والتعليم، حيث إن المدرسة هي المحضن الرئيس لأي محاولة نهضوية حقيقية. ولما كان التعليم يتأثر بنظرة المجتمع إلى نفسه، فقد أصبحت قضية الهوية لا تنفك عن التعليم ومشكلاته، خاصة أن اللغة مكوّن رئيس في تشكيل هوية الشعوب.
تتكوّن التركيبة السكانية للمغرب الكبير أساسا من العرب والأمازيغ الذين تمازجوا وتعايشوا، مع احتفاظ جزء مهم من المنطقة بلهجاتها وعاداتها الأمازيغية الخاصة. كما عرف المغرب الكبير الاستعمار الفرنسي الذي مارس سياسات اقتصادية وسياسية وإدارية ولغوية متقاربة.
هذا الوضع الجغرافي والتاريخي الخاص فرض على المنطقة ما يعرف بـ: مشكلة الهوية. ولما كانت علاقة الثقافات المحلية للمغاربيين بالثقافة الفرنسية في قلب هذه المشكلة.. فقد صار لقضية الهوية خصوصية أخرى، وهي أنها تـُطرح في إطار لغوي، بحيث لا يمكن الولوج إلى فهم مسألة هوية المنطقة ودراسة أصولها وآثارها.. دون التوقف عند قضية مكانة اللغة الفرنسية بها.
وتتفاوت دول المغرب الكبير في درجة الصلة بين الهوية واللغة، لكنه تفاوت في الدرجة لا في طبيعة المشكلة.
وقد اخترنا حصر الدراسة في المغرب لأنه المختبر اللغوي المثالي للمغرب الكبير كله، وواحد من أهم المختبرات اللغوية على مستوى الوطن العربي، فهو أكبر بلد أمازيغي في العالم وتنشط به الحركة الأمازيغية الحديثة التي أعادت طرح سؤال الهوية، وفيه أيضا أقلية تعرف اللغة الإسبانية.. لذلك فوضعه اللغوي هو الأكثر تعقيدا والأصعب في الدراسة من جميع الدول المغاربية الأخرى، لدرجة يمكن وصفه بـ"الفوضى اللغوية".
لذلك إذا نجح المغرب في عقد صلح الهوية واللغة –خاصة على مستوى المدرسة-، فمن باب أولى أن ينجح غيره من البلاد المغاربية والعربية.
لذلك خصصنا الفصل الأول لقضية الهوية، مع تركيز خاص على هوية المغرب الأقصى ومكوناتها وخصوصياتها.. كما خصصنا الفصل الرابع لسياسة فرض اللغة الفرنسية، والتي تسمى بالفرنكفونية، فعرفنا بهذه السياسة وبأساليبها وآثارها.. وبالوظائف التي تقوم بها هذه اللغة في المجتمع المغربي.
وبالرغم من محاربة الاستعمار الفرنسي للعربية، ومن تعثر سياسة التعريب في التعليم المغربي بعد الاستقلال، ومن سياسة الفرنكفونية اليوم.. فإنها ما زالت قادرة على أداء وظائفها الحضارية الثلاث: الوظيفة العقدية، والوحدوية، ثم الرسمية في الإدارة والإعلام.. وفي كل مؤسسات الدولة.. وهذا لا ينفي أن الفصحى بالمغرب تمر بأزمة حقيقية جراء احتكار اللغة الفرنسية خاصة لمختلف المجالات الحيوية في التعليم والإدارة والمؤسسات المالية والإعلام، وهذا ما تسبب في ضعف أدائها الوظيفي في الحياة العامة. لذلك أوردنا بعض عناصر خطة وطنية فاعلة للسياسة اللغوية للنهوض العلمي والحضاري بالعربية.. هذا وغيره كان موضوع الفصل الثاني.
وقد زاد اقتراح العامية الدارجة باعتبارها بديلا للعربية الفصحى في إضفاء تعقيد آخر على المشكلة. لذلك عقدنا الفصل الثالث لهذا الموضوع. إذ نشأت دعوة لاستعمال العامية في جميع المجالات، ويحاول أصحابها التنظير لها والتأصيل اللساني لاستخدامها، ويديرون صراعا لغويا عبر وضع اللغة العربية وحدها في جانب، ووضع الفرنسية والعامية والأمازيغية مجتمعة في جانب مقابل.
أما الفصل الخامس فيتعلق بالقضية الأمازيغية، فقد طرأ طارئ حديث جدا على الساحة المغاربية، وهو تبلور حركة سياسية وثقافية جعلت من الأمازيغية محور نشاطها وأساس مطالبها. هذه الحركة تحاول بناء نوع من "القومية الأمازيغية".. نوع غير متضح الملامح إلى حدّ الآن، لكن المؤكد أن اللغة الأمازيغية تشكل أساسه الأكبر، بل روحه حقا.
ولذلك نفهم لماذا كان شعار "اللغة الأمازيغية" هو السائد لدى هذا التيار الفكري والسياسي منذ نشأته إلى اليوم، حتى صار المدخل الرئيس "للهوية الأمازيغية" هو موضوع اللغة الأمازيغية.. وبهذا انصبت الجهود على معيرة اللهجات الأمازيغية ومحاولة بناء لغة موحدة، ثم السعي إلى تدريسها بالمدارس العمومية ونشرها بالتدريج باعتبارها لغة وطنية أو رسمية.. لذلك فالمسألة الأمازيغية تحتاج من الجميع إلى وقفة هادئة للتأمل والمراجعة.
أما الفصل الأخير فكان عن إشكالية لغة التدريس في المدرسة المغربية، اقترحنا فيه نموذجا محددا يتمثل في التعريب المدعوم بالتعدد اللغوي، مما يعين على وضع أسس متينة لاستقرار لساني متكامل، تحتل فيه العربية الفصحى موقعها المناسب، وتكون فيه اللغات الأمازيغية، أو اللغة الواحدة الممعيرة، لغات وطنية تُدرس وتُطور.. وتكون فيه أيضا اللغات الأجنبية لغات للدراسة لا للتدريس، مع ضمان هامش مهم من التعبير والتواصل الشفهي باللهجات العامية، في إطار متوازن ضمن سياسة لغوية وطنية فاعلة.
إن غاية هذه الدراسة هي المساهمة في حلّ مشكلة الهوية في صلتها بظاهرة الصراع اللغوي في المغرب، ووضع معالم سياسة لغوية رشيدة لا تمزّق النسيج الاجتماعي المغربي الذي تكوّن عبر قرون، كما لا تكون سببا في الفشل المدرسي واللغوي بكثرة اللغات وتصادمها..
إلياس بلكا
موضوع اللغة وتعلمها، سواء كانت لغة الأم، أو لغة وطنية أخرى، أو لغة أجنبية.. من الموضوعات المهمة التي لم يوليها الفكر الإسلامي الحديث ما تستحقه من جهد وبحوث ودراسات.. لذلك اشتغلت مع الدكتور محمد حراز –وهو أستاذ جامعي متخصص في مهن التربية والتكوين- على تأليف مشترك في الموضوع، فوضعنا – بحمد الله- كتابا بعنوان: "إشكالية الهوية والتعدد اللغوي بالمغرب العربي. المغرب نموذجا". وقد صدر هذا الكتاب في هذا الأسبوع عن "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية"، ومقره أبو ظبي.
وموضوع هذا الكتاب هو العلاقة بين الهوية واللغة في المغرب الكبير، وآثار ذلك على التربية والتعليم، حيث إن المدرسة هي المحضن الرئيس لأي محاولة نهضوية حقيقية. ولما كان التعليم يتأثر بنظرة المجتمع إلى نفسه، فقد أصبحت قضية الهوية لا تنفك عن التعليم ومشكلاته، خاصة أن اللغة مكوّن رئيس في تشكيل هوية الشعوب.
تتكوّن التركيبة السكانية للمغرب الكبير أساسا من العرب والأمازيغ الذين تمازجوا وتعايشوا، مع احتفاظ جزء مهم من المنطقة بلهجاتها وعاداتها الأمازيغية الخاصة. كما عرف المغرب الكبير الاستعمار الفرنسي الذي مارس سياسات اقتصادية وسياسية وإدارية ولغوية متقاربة.
هذا الوضع الجغرافي والتاريخي الخاص فرض على المنطقة ما يعرف بـ: مشكلة الهوية. ولما كانت علاقة الثقافات المحلية للمغاربيين بالثقافة الفرنسية في قلب هذه المشكلة.. فقد صار لقضية الهوية خصوصية أخرى، وهي أنها تـُطرح في إطار لغوي، بحيث لا يمكن الولوج إلى فهم مسألة هوية المنطقة ودراسة أصولها وآثارها.. دون التوقف عند قضية مكانة اللغة الفرنسية بها.
وتتفاوت دول المغرب الكبير في درجة الصلة بين الهوية واللغة، لكنه تفاوت في الدرجة لا في طبيعة المشكلة.
وقد اخترنا حصر الدراسة في المغرب لأنه المختبر اللغوي المثالي للمغرب الكبير كله، وواحد من أهم المختبرات اللغوية على مستوى الوطن العربي، فهو أكبر بلد أمازيغي في العالم وتنشط به الحركة الأمازيغية الحديثة التي أعادت طرح سؤال الهوية، وفيه أيضا أقلية تعرف اللغة الإسبانية.. لذلك فوضعه اللغوي هو الأكثر تعقيدا والأصعب في الدراسة من جميع الدول المغاربية الأخرى، لدرجة يمكن وصفه بـ"الفوضى اللغوية".
لذلك إذا نجح المغرب في عقد صلح الهوية واللغة –خاصة على مستوى المدرسة-، فمن باب أولى أن ينجح غيره من البلاد المغاربية والعربية.
لذلك خصصنا الفصل الأول لقضية الهوية، مع تركيز خاص على هوية المغرب الأقصى ومكوناتها وخصوصياتها.. كما خصصنا الفصل الرابع لسياسة فرض اللغة الفرنسية، والتي تسمى بالفرنكفونية، فعرفنا بهذه السياسة وبأساليبها وآثارها.. وبالوظائف التي تقوم بها هذه اللغة في المجتمع المغربي.
وبالرغم من محاربة الاستعمار الفرنسي للعربية، ومن تعثر سياسة التعريب في التعليم المغربي بعد الاستقلال، ومن سياسة الفرنكفونية اليوم.. فإنها ما زالت قادرة على أداء وظائفها الحضارية الثلاث: الوظيفة العقدية، والوحدوية، ثم الرسمية في الإدارة والإعلام.. وفي كل مؤسسات الدولة.. وهذا لا ينفي أن الفصحى بالمغرب تمر بأزمة حقيقية جراء احتكار اللغة الفرنسية خاصة لمختلف المجالات الحيوية في التعليم والإدارة والمؤسسات المالية والإعلام، وهذا ما تسبب في ضعف أدائها الوظيفي في الحياة العامة. لذلك أوردنا بعض عناصر خطة وطنية فاعلة للسياسة اللغوية للنهوض العلمي والحضاري بالعربية.. هذا وغيره كان موضوع الفصل الثاني.
وقد زاد اقتراح العامية الدارجة باعتبارها بديلا للعربية الفصحى في إضفاء تعقيد آخر على المشكلة. لذلك عقدنا الفصل الثالث لهذا الموضوع. إذ نشأت دعوة لاستعمال العامية في جميع المجالات، ويحاول أصحابها التنظير لها والتأصيل اللساني لاستخدامها، ويديرون صراعا لغويا عبر وضع اللغة العربية وحدها في جانب، ووضع الفرنسية والعامية والأمازيغية مجتمعة في جانب مقابل.
أما الفصل الخامس فيتعلق بالقضية الأمازيغية، فقد طرأ طارئ حديث جدا على الساحة المغاربية، وهو تبلور حركة سياسية وثقافية جعلت من الأمازيغية محور نشاطها وأساس مطالبها. هذه الحركة تحاول بناء نوع من "القومية الأمازيغية".. نوع غير متضح الملامح إلى حدّ الآن، لكن المؤكد أن اللغة الأمازيغية تشكل أساسه الأكبر، بل روحه حقا.
ولذلك نفهم لماذا كان شعار "اللغة الأمازيغية" هو السائد لدى هذا التيار الفكري والسياسي منذ نشأته إلى اليوم، حتى صار المدخل الرئيس "للهوية الأمازيغية" هو موضوع اللغة الأمازيغية.. وبهذا انصبت الجهود على معيرة اللهجات الأمازيغية ومحاولة بناء لغة موحدة، ثم السعي إلى تدريسها بالمدارس العمومية ونشرها بالتدريج باعتبارها لغة وطنية أو رسمية.. لذلك فالمسألة الأمازيغية تحتاج من الجميع إلى وقفة هادئة للتأمل والمراجعة.
أما الفصل الأخير فكان عن إشكالية لغة التدريس في المدرسة المغربية، اقترحنا فيه نموذجا محددا يتمثل في التعريب المدعوم بالتعدد اللغوي، مما يعين على وضع أسس متينة لاستقرار لساني متكامل، تحتل فيه العربية الفصحى موقعها المناسب، وتكون فيه اللغات الأمازيغية، أو اللغة الواحدة الممعيرة، لغات وطنية تُدرس وتُطور.. وتكون فيه أيضا اللغات الأجنبية لغات للدراسة لا للتدريس، مع ضمان هامش مهم من التعبير والتواصل الشفهي باللهجات العامية، في إطار متوازن ضمن سياسة لغوية وطنية فاعلة.
إن غاية هذه الدراسة هي المساهمة في حلّ مشكلة الهوية في صلتها بظاهرة الصراع اللغوي في المغرب، ووضع معالم سياسة لغوية رشيدة لا تمزّق النسيج الاجتماعي المغربي الذي تكوّن عبر قرون، كما لا تكون سببا في الفشل المدرسي واللغوي بكثرة اللغات وتصادمها..
Published on May 03, 2014 14:29
April 19, 2014
April 18, 2014
الأستاذ محمد مبشوش يصدر أول كتبه: تحولات المسيحية من خلال رسائل بولس.
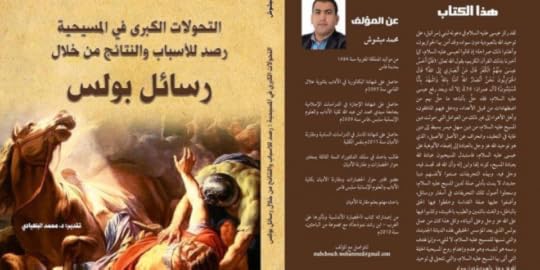 اصدر مؤخراً الباحث محمد مبشوش من مواليد مدينة فاس سنة 1984 ، طالب باحث بسلك الدكتوراه في تخصص “مقارنة الاديان” بكلية الآداب سايس فاس، وهو عضو بمختبر حوار الحضارات ومقارنة الأديان المتواجد بنفس الكلية. كتابا قيما يحمل عنوان “التحولات الكبرى في المسيحية رصد للأسباب والنتائج من خلال رسائل بولس”، عن دار الحكمة للنشر والتوزيع بالجمهورية العربية مصر، .
اصدر مؤخراً الباحث محمد مبشوش من مواليد مدينة فاس سنة 1984 ، طالب باحث بسلك الدكتوراه في تخصص “مقارنة الاديان” بكلية الآداب سايس فاس، وهو عضو بمختبر حوار الحضارات ومقارنة الأديان المتواجد بنفس الكلية. كتابا قيما يحمل عنوان “التحولات الكبرى في المسيحية رصد للأسباب والنتائج من خلال رسائل بولس”، عن دار الحكمة للنشر والتوزيع بالجمهورية العربية مصر، .والذي هو في الأصل عبارة عن رسالة ماستر نوقشت سنة 2011 تحت اشراف الدكتور “محمد البنعيادي” بكلية الآداب والعلوم الانسانية سايس ـــ فاس، تخصص “الدراسات السامية ومقارنة الأديان”، لينضاف إلى قائمة البحوث والاصدارات المتخصصة في مجال مقارنة الأديان، بعد إصدار صديقه “حفيظ اسليماني” كتاب “إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من خلال التوراة الإنجيل” ، بدوره رسالة ماستر. الكتاب حاول صاحبه حصر التغيير الذي طرأ على رسالة عيسى بن مريم عليه السلام، وكيف تحولت من ديانة ربانية المصدر توحيدية العقيدة، إلى ديانة بشرية لا تخرج عما جاءت به الأديان الوثنية لحضارات الشرق الأدنى القديم من معتقدات كمسألة تجسيد الاله وصلبه وقيامته من الموت بعد ثلاثة أيام صعوده إلى السماء.
وتبقي شخصية “بولس” وسائله من أهم الاسباب التي حولت رسالة المسيح من دين سهل ميسر وبسيط في تعاليمه، إلى دين معقد ومنحرف عن الاصل الذي جاء يدعو له، إلا وهو توحيد الله تعالى. للإشارة فهذا هو الكتاب الثاني للطالب الباحث “مبشوش محمد” بعد إصداره الأول صحبة مجموعة من الباحثين، والذي يحمل عنوان : الحضارة الأندلسية وتأثيرها على الغرب ـ ابن رشد نموذجا.
اصدر مؤخراً الباحث محمد مبشوش من مواليد مدينة فاس سنة 1984 ، طالب باحث بسلك الدكتوراه في تخصص “مقارنة الاديان” بكلية الآداب سايس فاس، وهو عضو بمختبر حوار الحضارات ومقارنة الأديان المتواجد بنفس الكلية. كتابا قيما يحمل عنوان “التحولات الكبرى في المسيحية رصد للأسباب والنتائج من خلال رسائل بولس”، عن دار الحكمة للنشر والتوزيع بالجمهورية العربية مصر، .
والذي هو في الأصل عبارة عن رسالة ماستر نوقشت سنة 2011 تحت اشراف الدكتور “محمد البنعيادي” بكلية الآداب والعلوم الانسانية سايس ـــ فاس، تخصص “الدراسات السامية ومقارنة الأديان”، لينضاف إلى قائمة البحوث والاصدارات المتخصصة في مجال مقارنة الأديان، بعد إصدار صديقه “حفيظ اسليماني” كتاب “إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من خلال التوراة الإنجيل” ، بدوره رسالة ماستر. الكتاب حاول صاحبه حصر التغيير الذي طرأ على رسالة عيسى بن مريم عليه السلام، وكيف تحولت من ديانة ربانية المصدر توحيدية العقيدة، إلى ديانة بشرية لا تخرج عما جاءت به الأديان الوثنية لحضارات الشرق الأدنى القديم من معتقدات كمسألة تجسيد الاله وصلبه وقيامته من الموت بعد ثلاثة أيام صعوده إلى السماء.
وتبقي شخصية “بولس” وسائله من أهم الاسباب التي حولت رسالة المسيح من دين سهل ميسر وبسيط في تعاليمه، إلى دين معقد ومنحرف عن الاصل الذي جاء يدعو له، إلا وهو توحيد الله تعالى. للإشارة فهذا هو الكتاب الثاني للطالب الباحث “مبشوش محمد” بعد إصداره الأول صحبة مجموعة من الباحثين، والذي يحمل عنوان : الحضارة الأندلسية وتأثيرها على الغرب ـ ابن رشد نموذجا.
Published on April 18, 2014 11:54
March 29, 2014
العقائد الإسلامية ومشكلة الفيزياء الحديثة وظهور الكم (الكوانتيك): سلسلة آفاق جديدة في البحوث الإسلامية.
سلسلة آفاق جديدة في البحوث الإسلامية. مشكلة الفيزياء الحديثة وظهور الكم (الكوانتيك):
إلياس بلكا
رأينا في بعض المقالات السابقة في هذه السلسلة كيف أننا بحاجة شديدة للاجتهاد في علم العقائد الإسلامية، وأن من مظاهر هذا الاجتهاد إعادة عرض هذه العقائد عرضا جديدا يستفيد من التطورات العلمية المختلفة التي شهدها عصرنا، سواء في العلوم الطبيعية والرياضية أو في العلوم الإنسانية.
والآن هذا مثال من الفيزياء، فأي جديد يمكن للفيزياء الكوانتية بالخصوص أن تحمله بالنسبة لهذه القضية؟
لكن قبل أي كلام في هذا الموضوع، ارتأيت أن أشرح- بإيجاز شديد- بعض المصطلحات المهمة في فيزياء الذرة، وأن أقدم باختصار أيضا بعض مشكلات الفيزياء الحديثة، وهو أمر لازم لفهم عام وإجمالي لعالم الكوانتيك الغامض.
عالم الذرة ومصطلحاته:
تتكون الذرة من النواة ومن مجموعة من الإلكترونات.
النواة تتكون من جزيئات تسمى البروتونات والنوترونات.
تكون النواة مشحونة بكهرباء موجبة تدور حولها إلكترونات مشحونة بكهرباء سالبة، ويعتقد أن للنواة بنية "حبيبية". ويمكن تشبيه الذرة بالمجموعة الشمسية، حيث تحتل الشمس المركز بينما تدور الكواكب حولها.
لكل من البروتون والنوترون كتلة معينة (حوالي 1,67 x 10-27 ). وأبسط العناصر الكيميائية هو الهليون، الذي له إلكترون واحد، يدور حول النواة، كما يفعل القمر حول الأرض.
أما الفوتون فجزيئة غير مادية، ذات كتلة وشحنة منعدمتين، أي صفر، وينتقل في الفراغ بسرعة الضوء (ثلاثمائة ألف كيلومتر في الثانية). والفوتون ليس مادة، وهو الذي يشكل الضوء.
نسمي الذرة ومكوناتها بالجزيئات أو الدقائق.
يعرف عالم الذرة بالعالم المجهري، وقد يقال له أيضا العالم الصغير، أو اللامتناهي في الصغر، وهو غير قابل للرؤية.
ويسمى عالم الأشياء المرئية - ولو بالمجهر- العالم العياني، أو العالم الكبير.
مشكلة الفيزياء الكلاسيكية :
اعتبر الفيزيائي الفرنسي دوبروكلي أن المشكلة الأساسية للفيزياء المعاصرة هو أنه في عالم الذرة يكون للجزئيات" سلوك" مزدوج، فهي أحيانا تتمثل باعتبارها دقائق، وأحيانا باعتبارها موجات، فطبيعتها مزدوجة، وهذا غير مفهوم.
جاءت الفيزياء الكوانتية لتحل هذا الإشكال الذي تبدى - أول ما تبدى- في الكهرباء… فقد لاحظ العلماء - في آخر القرن التاسع عشر- أن الكهرباء تبدو أحيانا كموجات منتشرة ومتصلة الحركة. وفي تجارب أخرى تبدو وكأنها مجموعة من الدقائق التي "يحمل" كل واحد منها شحنة جد صغيرة من الكهرباء أو الضوء.
بدا هذا لعلماء الفيزياء تناقضا وجوديا كبيرا. ولفهم ذلك علينا أن نعرف أولا الإطار العقلاني العام الذي اعتاد الفيزيائيون على العمل داخله، وهو الإطار الذي وضعته فيزياء نيوتن:
مبادئ العقلانية في فيزياء نيوتن :
استطاعت الفيزياء الميكانيكية التي وضعها نيوتن ليس فقط أن تكتشف بعض القوانين الكبرى التي تخضع لها الأجرام السماوية، وأن تفسر- إلى حد ما- هذه القوانين… بل - إلى ذلك- استطاعت هذه الفيزياء أن تشكل في الناس - وفي العلماء خصوصا- عقلية جديدة تمثلت أقوى صورها في المذهب الآلي الميكانيكي.
هذه العقلية كانت تفهم ظواهر الكون وفق المبادئ الآتية: 1- قوانين الفيزياء هي – بالدرجة الأولى – قوانين ميكانيكية.
2- الزمان المطلق والمكان المطلق هما الإطاران اللذان تحدث الظواهر وفقهما.
3- خصائص الأشياء مستقلة تماما عن الملاحِظ، وعن أدواته في الملاحظة والتجربة.
4- يمكن أن نتنبأ بصيرورة نسق فيزيائي ما، وفي كل لحظة، بالاعتماد فقط على معرفتنا بحالة هذا النسق في البداية.
ولهذا ترى الفيزياء الكلاسيكية أنه يوجد في الوجود شيئان، ولكل منهما طبيعة مادية مستقلة، أعني أن المادة إما أن تكون عبارة عن جسيمات صغيرة، وهي الدقائق، وإما أن تكون عبارة عن موجة.
الدقيقة شيء له وجود مستقل، تـُمثل بنقطة، وتحتل مساحة معينة، ولها في كل لحظة زمنية وضع وسرعة معينان. أي أن الدقيقة تتحرك وفق معادلة.
والموجة Onde شيء آخر، شيء ينتشر ويحتل المكان كله - لامساحة محددة-، وله طابع الاتصال والاستمرار لا الانقطاع، وقد تتداخل الموجات فيما بينها، ولذلك فالموجة تفسر ظواهر غير محددة في مكان معين..
ولهذا تفترض الفيزياء الكلاسيكية أن كل المتغيرات أو الكميات التي تستخدمها لها طابع الاستمرار والاتصال، حتى ما يتعلق منها بالدقائق؛ فالجسيم حين يتحرك مثلا، لا تتصور هذه الفيزياء أنه سيقفز بحركة متقطعة، على شاكلة طفرة النظام المعتزلي مثلا، بل انتقاله سيكون من مكان إلى مكان، فهو متصل في الفضاء؛ وهو انتقال يتم لحظة لحظة، فهو متصل في الزمان، وذلك بسرعة تتغير باستمرار، فتزداد – أو تنقص- شيئا فشيئا… كل شيء يحدث متصلا بنوع امتلاء.
ولذلك كان التعبير الأمثل لهذا الاتصال هو المعادلات التفاضلية، فهذه تصف بدقة تطور الأحداث – كالسرعة- في الزمان. ولولا هذه المعادلات ما وجدت فيزياء نيوتن أصلا.
ظهور الكم أو الكوانتيك:
والحاصل أنه لما ظهرت الفيزياء الجديدة - الكوانتيك- "وحَّدت" بين هذين النوعين من المادة. لقد اكتشفت أن جزيئات العالم المجهري - مثل الفوتونات والإلكترونات…- ليست في الواقع بأجسام جد لامتناهية في الصغر، ولا هي أيضا بموجات… وتبين أن الجسيم والموجة مجرد اصطلاحين تقريبيين لهما معنى فقط في عالم الأشياء الكبيرة. ووقع الاتفاق على تسمية مكونات عالم الذرة بـ: الكوانتون Quanton، أو الجزيئات الكوانتية.. فأصبحت الفيزياء التي تدرس هذا العالم تسمى بالكوانتيك.
وإن ساغ لنا - في إطار العقلانية المؤسسة على فيزياء نيوتن- أن نسأل ونبحث لكي نعرف ما هي الموجة، وما هي الدقيقة أو الجزيء… ففي الكوانتيك لا معنى لهذا السؤال. كل شيء يحدث كأن هذه الموجة ترتبط بجزيء، وتمثل درجة للاحتمال… احتمال وجود هذا الجزيء في نقطة معينة من الفضاء.
هذا - باختصار بالغ- أصل ظهور الكوانتيك، التي بلغت نضجها في العشرينيات - من القرن الماضي-، بفضل جهود علماء كثر أغلبهم ألمان، لعل أهمهم : بوهر، وهايزنبرج ، وأينـشتـين،
وشرودنكر، ودوبروكلي...
وهذه الفيزياء حاضرة اليوم بقوة في كثير من التخصصات الفيزيائية وغير الفيزيائية. وتعني كلمة " الفيزياء الكوانتية" مختلفة مجالات الفيزياء النظرية والتطبيقية التي تعتمد أساسا على قوانين ومفاهيم الميكانيكا الكوانتية.
يتبع..
Published on March 29, 2014 01:33
March 26, 2014
في أفق تطوير علم العقائد الإسلامية: مشكلة الفيزياء الحديثة وظهور الكم (الكوانتيك).
المقال القادم بجمعة 28 مارس بجريدة الأخبار، ملحق دين وفكر (يـُـنشر السبت في هذه المدونة):
في أفق تطوير علم العقائد الإسلامية:
مشكلة الفيزياء الحديثة وظهور الكم (الكوانتيك):
سلسلة: آفاق جديدة في البحوث الإسلامية.أكتب هنا عن بعض القضايا المهمة التي تحتاج إلى جهود الباحثين والمؤلفين، خاصة من جيل الشباب.. فهي قضايا مهمة بالنسبة لحاضر الأمة الإسلامية ومستقبلها، بل إن نهضتنا المنشودة تقوم جزئيا على الدراسة العميقة والجادة لهذه المشكلات وأمثالها، وتقديم الحلول المناسبة لها: حلول تراعي الدين وقواعده، دون أن تغفل عن العصر وطبيعته.
سلسلة: آفاق جديدة في البحوث الإسلامية.أكتب هنا عن بعض القضايا المهمة التي تحتاج إلى جهود الباحثين والمؤلفين، خاصة من جيل الشباب.. فهي قضايا مهمة بالنسبة لحاضر الأمة الإسلامية ومستقبلها، بل إن نهضتنا المنشودة تقوم جزئيا على الدراسة العميقة والجادة لهذه المشكلات وأمثالها، وتقديم الحلول المناسبة لها: حلول تراعي الدين وقواعده، دون أن تغفل عن العصر وطبيعته.
Published on March 26, 2014 14:25
March 14, 2014
د. حمدي عبد الرحمن: مسلمو أفريقيا بين مطرقة الإرهاب وسندان الإبادة.
مسلمو أفريقيا بين مطرقة الإرهاب وسندان الإبادة
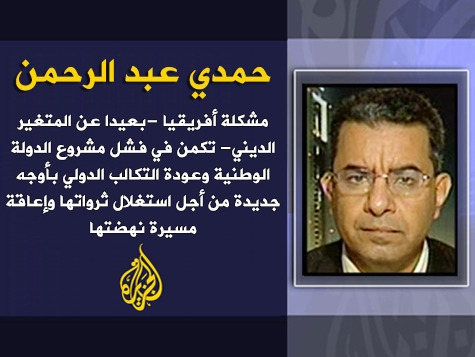
ثنائية الإرهاب والإبادة
أزمة فهم
ما العمل؟
توقفت مليّا عند مشاهد الرعب التي تعرض لها مسلمو أفريقيا الوسطى، والتي تعيد إلى الأذهان تجربة الحروب الدينية في العصور الوسطى.
أليس من العار على الأمم المتحضرة التي تتغنى بقيم الحريات الدينية والمسؤولية من أجل الحماية أن تحدث عمليات إبادة وتهجير قسري واسع النطاق لآلاف المسلمين ولا يحرك أحد ساكنا؟
قلت لنفسي لعلها مبالغات وهواجس نظريات المؤامرة التي تسيطر على العقل الجمعي السائد في العالم الإسلامي، فابتعدت عن أحاديث الاستنكار والاستجداء التي صدرت عن بعض مؤسساتنا الإسلامية واعتمدت على تقارير دولية حقوقية يفترض فيها الحياد والموضوعية.
لقد أكدت منظمة العفو الدولية في أحدث تقرير لها صادر في 11 فبراير/شباط 2014 أن "الهجمات ضد المسلمين في أفريقيا الوسطى ارتكبت بقصد صريح هو التهجير القسري لهم، لقد رأت المليشيات المسيحية المناهضة للوجود الإسلامي أن المسلمين بمثابة أجانب غرباء عليهم الاختيار بين مغادرة البلاد أو التعرض للقتل".
"هذا المقال يسعى لرصد الحالة الإسلامية في أفريقيا، والتي تعبر عن تناقضات خبرة ما بعد الاستعمار وفشل بناء الدولة المدنية الحديثة، وغياب الفهم بسبب غلبة النموذج المعرفي الغربي المسيطر
"ويسعى هذا المقال لرصد الحالة الإسلامية في أفريقيا عموما، والتي تعبر عن تناقضات خبرة ما بعد الاستعمار، وفشل بناء الدولة المدنية الحديثة من جهة، وغياب الفهم بسبب غلبة النموذج المعرفي الغربي المسيطر من جهة أخرى.
ولعل ذلك كله يدفع إلى التساؤل عن إمكانية التفسير والفهم المتعلق بأزمات مسلمي أفريقيا.
لعل ما يثير الفزع والاستغراب في آن واحد هو أن عمليات التهجير القسري للمسلمين في أفريقيا الوسطى تمت بمباركة -بل ومشاركة- الحكومة، في حين وقفت قوات "السلام" الفرنسية مكتوفة اليدين.
إننا أمام وضع مأساوي انشغل عنه العالم الإسلامي بسبب هيمنة ملفات مصر وسوريا وليبيا وغيرها من مناطق القلب. لقد وقع التهجير القسري لكافة السكان المسلمين في مدن وقرى كثيرة، أما من بقي فقد عجز عن توفير وسيلة خروج آمن فدفعه الخوف إلى الاحتماء بساحات المساجد والكنائس.
وطبقا لبعض المصادر الدولية، فقد تم تهجير نحو 67 ألف مسلم، أي ما يشكل نحو 10% من جملة السكان المسلمين.
يمكن للمرء في مثل هذه النوازل أن يلجأ إلى قيم المحن والابتلاء بمفهومها الإسلامي، ويتذكر قول مؤرخنا الكبير عبد الرحمن الجبرتي "يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف"، عندما شاهد عدوان نابليون وجنده على طلاب الأزهر وشيوخه بالقنابل. قد يقول قائل إن مسلمي أفريقيا الوسطى أقلية لا تتجاوز 15% من إجمالي السكان، والأقليات في عالمنا المعاصر تعاني كثيرا من الظلم والاضطهاد، ولا شك أن ذلك اقتراب تبريري ذرائعي غير مقبول.
وربما يدفع ذلك إلى النظر في أحوال كتلة الإسلام الحصينة في الغرب الأفريقي التي كان لها دور رائد في بناء الحضارة الإسلامية.
إذ يكفي أن نتذكر جوهرة الصحراء تمبكتو وممالك مالي وكانم وبورنو والصنغاي، على أن متابعة الراديكالية الإسلامية في هذه المنطقة مثل خطاب بوكوحرام في نيجيريا الذي تحول من العداء للدولة "الكافرة" إلى العداء لكل من الدولة والمجتمع معا باعتبارهما لا يطبقان شرع الله، تظهر أن مسلمي الغرب الأفريقي ليسوا أفضل حالا من مسلمي الوسط.
وإذا كان حال المسلمين في الجنوب الأفريقي يعبر عن تناقضات الخطاب الإسلامي عموما في مرحلة ما بعد الاستعمار، حيث نجده ينحو صوب السلفية الدعوية تارة أو الراديكالية الجهادية تارة أخرى، فإنهم عموما أقليات تعيش في ظل مجتمعات تهيمن عليها عقائد تقليدية أو تعاليم مسيحية.
لم يكن غريبا أن نرى تباين الخطاب الدعوي الذي تبناه الراحل أحمد ديدات في مواجهة الخطاب المسيحي المهيمن، عن خطاب الإسلام التقدمي الذي يطرحه المفكر الجنوب أفريقي فريد إسحق.
لا أحسب أن الشمال والشرق الأفريقي بأغلبيته المسلمة أفضل حالا كذلك، فالخطاب الصوفي الجهادي، والذي قام بدور مهم في محاربة الاستعمار الغربي كما حدث في بلاد الصومال وليبيا والجزائر والمغرب، قد تراجع القهقرى ليحل محله خطاب راديكالي يعيد الاعتبار لمفهوم الأممية الإسلامية بعناصره القائمة على الخلافة وتحقيق حلم الجامعة الإسلامية، وهو ما يعني تقسيم المعمورة إلى دار للإسلام وأخرى للحرب.
ويعبر خطاب تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي والجماعات الموالية له في شرق أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء عن هذه التحول الجذري في الخطاب الإسلامي، الذي يعتبره الكثير من القوى الإقليمية والدولية أحد تجليات الإرهاب المعولم.
ما الذي حدث خطأ لقارة الإسلام؟
لقد كتب هوبير ديشامب عام 1963 واصفا التوسع الإسلامي في أفريقيا بقوله "لم يقف أي حاجز أمام زحف الإسلام بأفريقيا، فقد انتشر بالشمال في وقت مبكر، ثم تخطى الصحراء وزحف خلفها، وعبر من الجزيرة العربية للساحل الشرقي منذ عصره الأول، وتخطى هذا الساحل إلى المناطق الداخلية إلى كينيا وتنجانيقا، واقتحم نطاق الغابات في قلب أفريقيا، ونفذ إلى هضبة البحيرات وتدفق إلى الهضبة الحبشية، وانتشر على طول الساحل الغربي، ودخل جنوب أفريقيا مع المهاجرين المسلمين من سكان شبه القارة الهندية وماليزيا، ولا زال ينتشر حتى اليوم إلى آفاق جديدة".
"الزحف الإسلامي على حساب الأديان الأخرى بأفريقيا أدى إلى وجود دعاية ديماجوجية في الكتابات الأوروبية لا تزال مسيطرة حتى اليوم، حيث بدأ الحديث منذ نهاية القرن 19 عن ظاهرة الإسلام الأسود
"باعتقادي أن الحالة الإسلامية في أفريقيا تحتاج إلى إعادة فهم ومراجعة لعدة اعتبارات:
الاعتبار الأول معرفي ومنهجي، فقد أدى الزحف الإسلامي على حساب الأديان التقليدية والمسيحية في أفريقيا إلى وجود عملية دعاية ديماجوجية في الكتابات الأوروبية المتخصصة، لا تزال مسيطرة حتى اليوم، حيث بدأ الحديث منذ نهاية القرن 19 عن ظاهرة الإسلام الأسود. إنه إسلام خضع لعملية إعادة صياغة وتفسير، فأضحى أكثر توافقا مع الخصائص النفسية للأجناس السوداء.
وقد تجاوب بعض المفكرين الأفارقة -ولا سيما في أفريقيا الفرانكفونية- مع هذه الدعوة، وقالوا بوجود مصادر محلية للإسلام أو ما أطلق عليه "أفرقة الإسلام".
ولعل مأساة كل من السودان وأفريقيا الوسطى تعبر مرة أخرى عن انحياز العقل الغربي في دراسة كل ما يتعلق بالظاهرة الإسلامية في أفريقيا.
فمنذ صعود الإسلاميين للحكم في السودان عام 1989 والغرب يحاول إبراز البعد الديني للصراع هناك، وتصويره على غير الواقع بأنه مواجهة بين الإسلام والمسيحية.
وهنا نذكر جهود الممثل جورج كلوني، الذي حاول بكل جهده تصوير الحرب الأهلية في السودان على أنها تطهير عرقي، وفي عام 2001 أخرج جيمس ميلر فيلما وثائقيا بعنوان "الحرب غير المقدسة: الإبادة الجماعية للمسيحيين في السودان".
والعجيب أن أحدا لم يطرح السؤال الأهم، وهو: ماذا لو أن آلاف السكان المسيحيين قد قتلوا أو هجروا من دولة إسلامية قياسا على ما حدث في أفريقيا الوسطى؟
الإجابة معروفة بالقطع، وهي الحديث عن العنف الإسلامي، وعدم احترام الحقوق والحريات الدينية، وهو ما يعني ضرورة إعمال مبدأ التدخل الدولي الإنساني.
أما الاعتبار الثاني، فهو مرتبط بطبيعة الموروث الاستعماري وعلاقته بالظاهرة الإسلامية في أفريقيا. فالدولة الأفريقية هي نتاج استعماري، أي أن أساسها مصطنع، فالإقليم -وهو وعاء الدولة- ليس إلا نتاج تحديد تعسفي من السلطة الاستعمارية في إطار منظومة القوى التي حكمت عملية التكالب الاستعماري الأولى.
وقد قام المستعمر بخلق نخبة أفريقية مثقفة ومتشبعة بالتقاليد الغربية العلمانية حتى إذا صار الحكم إليها في مرحلة ما بعد الاستقلال عمدت إلى الحفاظ على هذا الإرث الاستعماري في الحكم والإدارة.
وقد أدى ذلك إلى نجاح هذه النخبة الحاكمة الجديدة المتغربة في ما فشل فيه المستعمرون من قبل، ولعلنا نتذكر هنا حالات السنغال في عهد سنجور، والصومال في عهد سياد بري، وجزر القمر في عهد علي صويلح.
والاعتبار الثالث، هو الذي يفسر لنا صعود الخطاب الراديكالي الموسوم بالإرهاب غربيا ومحليا في أغلب الأحوال، ويتمثل في فشل مشروع الدولة الوطنية والتي قامت على تبني أيديولوجيات علمانية كالاشتراكية والليبرالية.
لقد أدى غياب الديموقراطية وانتشار الفساد في الواقع الأفريقي -بما يعنيه من انهيار نموذج النهضة الأفريقي العلماني- إلى ظهور رؤى بديلة تعتمد على مرجعية دينية.
يمكن أن نفهم ذلك الاتجاه من خلال مراجعة تجارب تطبيق الشريعة الإسلامية في شمال نيجيريا، وظهور الشباب المجاهدين في الصومال، وتنامي الحركات الجهادية في إقليم الساحل والصحراء.
ومن الملفت للانتباه أن خطاب الحركات الإسلامية الراديكالية المعاصرة في أفريقيا قد استلهم أصوله الفكرية من ثلاثة منابع قد تبدو -لأول وهلة غير متجانسة- إذ شكل التراث الفكري لحركة الإخوان المسلمين في مصر مصدرا ملهما للإسلام الحركي في كثير من أنحاء أفريقيا، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فقد أثر تراث أبو الأعلى المودودي على نشأة وتطور كثير من الحركات الإسلامية في شرق وجنوب أفريقيا بحكم وجود جاليات آسيوية كبيرة هناك. أما المنبع الثالث، فإنه يرتبط بتقاليد الثورة الإيرانية التي تبنت خطابا إسلاميا راديكاليا يدعو إلى إقامة الدولة الإسلامية المستقلة.
نحن بحاجة إلى الفهم والخروج من إسار هذه الحدية المؤدلجة التي أضحت تحصر الحالة الإسلامية في أفريقيا بين مطرقة الإرهاب وسندان المؤامرة الغربية والإبادة الجماعية.
"التحول الفارق في جدلية العلاقة بين الدين والسياسة أفريقيا يعود لأسباب ترجع في معظمها إلى سياق الفقر والتخلف الذي تعيشه المجتمعات المسلمة، بالإضافة إلى تحولات ما بعد "11 سبتمبر"
"لقد سارعت كثير من الدول إلى تبني الحلول الأمنية المعتمدة على الداخل كما في نيجيريا، أو بمساندة ظهير خارجي كما هو الحال في الصومال ومالي، وهو ما يعني تراجع الحلول التوافقية التي تشكل تيارا عاما يهدف إلى إعادة بناء الدولة الوطنية كما حدث في تجربة جنوب أفريقيا بعد سقوط نظام التفرقة العنصرية.ولا شك أن مخاطر استعداء المجتمع لمواجهة هذه الحركات الراديكالية، كما حدث في التجربة النيجيرية حيث تم تشكيل مليشيات مجتمعية لمواجهة عنف بوكوحرام، قد يفضي إلى نتائج سلبية تنال من تجانس المجتمع واستقراره.
إن مشكلة أفريقيا -بعيدا عن المتغير الديني- تكمن في فشل مشروع الدولة الوطنية الذي يؤكد على قيم المواطنة والمساواة والعدالة وخلق هوية واحدة للجميع، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، في عودة التكالب الدولي بأوجه جديدة من أجل استغلال ثروات أفريقيا وإعاقة مسيرة نهضتها.
أليست رائحة النفط واليورانيوم هي التي تفسر لنا سر التواجد الفرنسي والأميركي في كل من مالي وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان؟
وعليه، فإن تفسير الواقع المعيش للمجتمعات الإسلامية في أفريقيا لا بد أن يعتمد على الخبرة التاريخية، ويأخذ السياق الحضاري والديني لهذه المجتمعات بعين الاعتبار.
فالتحول الفارق في جدلية العلاقة بين الدين والسياسة أفريقيا -ولا سيما الموقف من علمانية الدولة- إنما يعزى إلى أسباب ترجع في معظمها إلى سياق الفقر والتخلف الذي تعيشه المجتمعات المسلمة، بالإضافة إلى التحولات الإقليمية والدولية التي شهدتها أفريقيا في أعقاب أحداث "11 سبتمبر/أيلول".
المصدر:الجزيرة
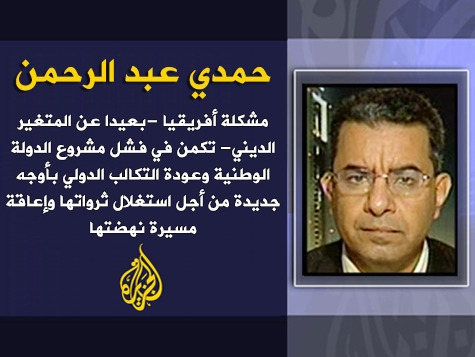
ثنائية الإرهاب والإبادة
أزمة فهم
ما العمل؟
توقفت مليّا عند مشاهد الرعب التي تعرض لها مسلمو أفريقيا الوسطى، والتي تعيد إلى الأذهان تجربة الحروب الدينية في العصور الوسطى.
أليس من العار على الأمم المتحضرة التي تتغنى بقيم الحريات الدينية والمسؤولية من أجل الحماية أن تحدث عمليات إبادة وتهجير قسري واسع النطاق لآلاف المسلمين ولا يحرك أحد ساكنا؟
قلت لنفسي لعلها مبالغات وهواجس نظريات المؤامرة التي تسيطر على العقل الجمعي السائد في العالم الإسلامي، فابتعدت عن أحاديث الاستنكار والاستجداء التي صدرت عن بعض مؤسساتنا الإسلامية واعتمدت على تقارير دولية حقوقية يفترض فيها الحياد والموضوعية.
لقد أكدت منظمة العفو الدولية في أحدث تقرير لها صادر في 11 فبراير/شباط 2014 أن "الهجمات ضد المسلمين في أفريقيا الوسطى ارتكبت بقصد صريح هو التهجير القسري لهم، لقد رأت المليشيات المسيحية المناهضة للوجود الإسلامي أن المسلمين بمثابة أجانب غرباء عليهم الاختيار بين مغادرة البلاد أو التعرض للقتل".
"هذا المقال يسعى لرصد الحالة الإسلامية في أفريقيا، والتي تعبر عن تناقضات خبرة ما بعد الاستعمار وفشل بناء الدولة المدنية الحديثة، وغياب الفهم بسبب غلبة النموذج المعرفي الغربي المسيطر
"ويسعى هذا المقال لرصد الحالة الإسلامية في أفريقيا عموما، والتي تعبر عن تناقضات خبرة ما بعد الاستعمار، وفشل بناء الدولة المدنية الحديثة من جهة، وغياب الفهم بسبب غلبة النموذج المعرفي الغربي المسيطر من جهة أخرى.
ولعل ذلك كله يدفع إلى التساؤل عن إمكانية التفسير والفهم المتعلق بأزمات مسلمي أفريقيا.
لعل ما يثير الفزع والاستغراب في آن واحد هو أن عمليات التهجير القسري للمسلمين في أفريقيا الوسطى تمت بمباركة -بل ومشاركة- الحكومة، في حين وقفت قوات "السلام" الفرنسية مكتوفة اليدين.
إننا أمام وضع مأساوي انشغل عنه العالم الإسلامي بسبب هيمنة ملفات مصر وسوريا وليبيا وغيرها من مناطق القلب. لقد وقع التهجير القسري لكافة السكان المسلمين في مدن وقرى كثيرة، أما من بقي فقد عجز عن توفير وسيلة خروج آمن فدفعه الخوف إلى الاحتماء بساحات المساجد والكنائس.
وطبقا لبعض المصادر الدولية، فقد تم تهجير نحو 67 ألف مسلم، أي ما يشكل نحو 10% من جملة السكان المسلمين.
يمكن للمرء في مثل هذه النوازل أن يلجأ إلى قيم المحن والابتلاء بمفهومها الإسلامي، ويتذكر قول مؤرخنا الكبير عبد الرحمن الجبرتي "يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف"، عندما شاهد عدوان نابليون وجنده على طلاب الأزهر وشيوخه بالقنابل. قد يقول قائل إن مسلمي أفريقيا الوسطى أقلية لا تتجاوز 15% من إجمالي السكان، والأقليات في عالمنا المعاصر تعاني كثيرا من الظلم والاضطهاد، ولا شك أن ذلك اقتراب تبريري ذرائعي غير مقبول.
وربما يدفع ذلك إلى النظر في أحوال كتلة الإسلام الحصينة في الغرب الأفريقي التي كان لها دور رائد في بناء الحضارة الإسلامية.
إذ يكفي أن نتذكر جوهرة الصحراء تمبكتو وممالك مالي وكانم وبورنو والصنغاي، على أن متابعة الراديكالية الإسلامية في هذه المنطقة مثل خطاب بوكوحرام في نيجيريا الذي تحول من العداء للدولة "الكافرة" إلى العداء لكل من الدولة والمجتمع معا باعتبارهما لا يطبقان شرع الله، تظهر أن مسلمي الغرب الأفريقي ليسوا أفضل حالا من مسلمي الوسط.
وإذا كان حال المسلمين في الجنوب الأفريقي يعبر عن تناقضات الخطاب الإسلامي عموما في مرحلة ما بعد الاستعمار، حيث نجده ينحو صوب السلفية الدعوية تارة أو الراديكالية الجهادية تارة أخرى، فإنهم عموما أقليات تعيش في ظل مجتمعات تهيمن عليها عقائد تقليدية أو تعاليم مسيحية.
لم يكن غريبا أن نرى تباين الخطاب الدعوي الذي تبناه الراحل أحمد ديدات في مواجهة الخطاب المسيحي المهيمن، عن خطاب الإسلام التقدمي الذي يطرحه المفكر الجنوب أفريقي فريد إسحق.
لا أحسب أن الشمال والشرق الأفريقي بأغلبيته المسلمة أفضل حالا كذلك، فالخطاب الصوفي الجهادي، والذي قام بدور مهم في محاربة الاستعمار الغربي كما حدث في بلاد الصومال وليبيا والجزائر والمغرب، قد تراجع القهقرى ليحل محله خطاب راديكالي يعيد الاعتبار لمفهوم الأممية الإسلامية بعناصره القائمة على الخلافة وتحقيق حلم الجامعة الإسلامية، وهو ما يعني تقسيم المعمورة إلى دار للإسلام وأخرى للحرب.
ويعبر خطاب تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي والجماعات الموالية له في شرق أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء عن هذه التحول الجذري في الخطاب الإسلامي، الذي يعتبره الكثير من القوى الإقليمية والدولية أحد تجليات الإرهاب المعولم.

ما الذي حدث خطأ لقارة الإسلام؟
لقد كتب هوبير ديشامب عام 1963 واصفا التوسع الإسلامي في أفريقيا بقوله "لم يقف أي حاجز أمام زحف الإسلام بأفريقيا، فقد انتشر بالشمال في وقت مبكر، ثم تخطى الصحراء وزحف خلفها، وعبر من الجزيرة العربية للساحل الشرقي منذ عصره الأول، وتخطى هذا الساحل إلى المناطق الداخلية إلى كينيا وتنجانيقا، واقتحم نطاق الغابات في قلب أفريقيا، ونفذ إلى هضبة البحيرات وتدفق إلى الهضبة الحبشية، وانتشر على طول الساحل الغربي، ودخل جنوب أفريقيا مع المهاجرين المسلمين من سكان شبه القارة الهندية وماليزيا، ولا زال ينتشر حتى اليوم إلى آفاق جديدة".
"الزحف الإسلامي على حساب الأديان الأخرى بأفريقيا أدى إلى وجود دعاية ديماجوجية في الكتابات الأوروبية لا تزال مسيطرة حتى اليوم، حيث بدأ الحديث منذ نهاية القرن 19 عن ظاهرة الإسلام الأسود
"باعتقادي أن الحالة الإسلامية في أفريقيا تحتاج إلى إعادة فهم ومراجعة لعدة اعتبارات:
الاعتبار الأول معرفي ومنهجي، فقد أدى الزحف الإسلامي على حساب الأديان التقليدية والمسيحية في أفريقيا إلى وجود عملية دعاية ديماجوجية في الكتابات الأوروبية المتخصصة، لا تزال مسيطرة حتى اليوم، حيث بدأ الحديث منذ نهاية القرن 19 عن ظاهرة الإسلام الأسود. إنه إسلام خضع لعملية إعادة صياغة وتفسير، فأضحى أكثر توافقا مع الخصائص النفسية للأجناس السوداء.
وقد تجاوب بعض المفكرين الأفارقة -ولا سيما في أفريقيا الفرانكفونية- مع هذه الدعوة، وقالوا بوجود مصادر محلية للإسلام أو ما أطلق عليه "أفرقة الإسلام".
ولعل مأساة كل من السودان وأفريقيا الوسطى تعبر مرة أخرى عن انحياز العقل الغربي في دراسة كل ما يتعلق بالظاهرة الإسلامية في أفريقيا.
فمنذ صعود الإسلاميين للحكم في السودان عام 1989 والغرب يحاول إبراز البعد الديني للصراع هناك، وتصويره على غير الواقع بأنه مواجهة بين الإسلام والمسيحية.
وهنا نذكر جهود الممثل جورج كلوني، الذي حاول بكل جهده تصوير الحرب الأهلية في السودان على أنها تطهير عرقي، وفي عام 2001 أخرج جيمس ميلر فيلما وثائقيا بعنوان "الحرب غير المقدسة: الإبادة الجماعية للمسيحيين في السودان".
والعجيب أن أحدا لم يطرح السؤال الأهم، وهو: ماذا لو أن آلاف السكان المسيحيين قد قتلوا أو هجروا من دولة إسلامية قياسا على ما حدث في أفريقيا الوسطى؟
الإجابة معروفة بالقطع، وهي الحديث عن العنف الإسلامي، وعدم احترام الحقوق والحريات الدينية، وهو ما يعني ضرورة إعمال مبدأ التدخل الدولي الإنساني.
أما الاعتبار الثاني، فهو مرتبط بطبيعة الموروث الاستعماري وعلاقته بالظاهرة الإسلامية في أفريقيا. فالدولة الأفريقية هي نتاج استعماري، أي أن أساسها مصطنع، فالإقليم -وهو وعاء الدولة- ليس إلا نتاج تحديد تعسفي من السلطة الاستعمارية في إطار منظومة القوى التي حكمت عملية التكالب الاستعماري الأولى.
وقد قام المستعمر بخلق نخبة أفريقية مثقفة ومتشبعة بالتقاليد الغربية العلمانية حتى إذا صار الحكم إليها في مرحلة ما بعد الاستقلال عمدت إلى الحفاظ على هذا الإرث الاستعماري في الحكم والإدارة.
وقد أدى ذلك إلى نجاح هذه النخبة الحاكمة الجديدة المتغربة في ما فشل فيه المستعمرون من قبل، ولعلنا نتذكر هنا حالات السنغال في عهد سنجور، والصومال في عهد سياد بري، وجزر القمر في عهد علي صويلح.
والاعتبار الثالث، هو الذي يفسر لنا صعود الخطاب الراديكالي الموسوم بالإرهاب غربيا ومحليا في أغلب الأحوال، ويتمثل في فشل مشروع الدولة الوطنية والتي قامت على تبني أيديولوجيات علمانية كالاشتراكية والليبرالية.
لقد أدى غياب الديموقراطية وانتشار الفساد في الواقع الأفريقي -بما يعنيه من انهيار نموذج النهضة الأفريقي العلماني- إلى ظهور رؤى بديلة تعتمد على مرجعية دينية.
يمكن أن نفهم ذلك الاتجاه من خلال مراجعة تجارب تطبيق الشريعة الإسلامية في شمال نيجيريا، وظهور الشباب المجاهدين في الصومال، وتنامي الحركات الجهادية في إقليم الساحل والصحراء.
ومن الملفت للانتباه أن خطاب الحركات الإسلامية الراديكالية المعاصرة في أفريقيا قد استلهم أصوله الفكرية من ثلاثة منابع قد تبدو -لأول وهلة غير متجانسة- إذ شكل التراث الفكري لحركة الإخوان المسلمين في مصر مصدرا ملهما للإسلام الحركي في كثير من أنحاء أفريقيا، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فقد أثر تراث أبو الأعلى المودودي على نشأة وتطور كثير من الحركات الإسلامية في شرق وجنوب أفريقيا بحكم وجود جاليات آسيوية كبيرة هناك. أما المنبع الثالث، فإنه يرتبط بتقاليد الثورة الإيرانية التي تبنت خطابا إسلاميا راديكاليا يدعو إلى إقامة الدولة الإسلامية المستقلة.

نحن بحاجة إلى الفهم والخروج من إسار هذه الحدية المؤدلجة التي أضحت تحصر الحالة الإسلامية في أفريقيا بين مطرقة الإرهاب وسندان المؤامرة الغربية والإبادة الجماعية.
"التحول الفارق في جدلية العلاقة بين الدين والسياسة أفريقيا يعود لأسباب ترجع في معظمها إلى سياق الفقر والتخلف الذي تعيشه المجتمعات المسلمة، بالإضافة إلى تحولات ما بعد "11 سبتمبر"
"لقد سارعت كثير من الدول إلى تبني الحلول الأمنية المعتمدة على الداخل كما في نيجيريا، أو بمساندة ظهير خارجي كما هو الحال في الصومال ومالي، وهو ما يعني تراجع الحلول التوافقية التي تشكل تيارا عاما يهدف إلى إعادة بناء الدولة الوطنية كما حدث في تجربة جنوب أفريقيا بعد سقوط نظام التفرقة العنصرية.ولا شك أن مخاطر استعداء المجتمع لمواجهة هذه الحركات الراديكالية، كما حدث في التجربة النيجيرية حيث تم تشكيل مليشيات مجتمعية لمواجهة عنف بوكوحرام، قد يفضي إلى نتائج سلبية تنال من تجانس المجتمع واستقراره.
إن مشكلة أفريقيا -بعيدا عن المتغير الديني- تكمن في فشل مشروع الدولة الوطنية الذي يؤكد على قيم المواطنة والمساواة والعدالة وخلق هوية واحدة للجميع، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، في عودة التكالب الدولي بأوجه جديدة من أجل استغلال ثروات أفريقيا وإعاقة مسيرة نهضتها.
أليست رائحة النفط واليورانيوم هي التي تفسر لنا سر التواجد الفرنسي والأميركي في كل من مالي وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان؟
وعليه، فإن تفسير الواقع المعيش للمجتمعات الإسلامية في أفريقيا لا بد أن يعتمد على الخبرة التاريخية، ويأخذ السياق الحضاري والديني لهذه المجتمعات بعين الاعتبار.
فالتحول الفارق في جدلية العلاقة بين الدين والسياسة أفريقيا -ولا سيما الموقف من علمانية الدولة- إنما يعزى إلى أسباب ترجع في معظمها إلى سياق الفقر والتخلف الذي تعيشه المجتمعات المسلمة، بالإضافة إلى التحولات الإقليمية والدولية التي شهدتها أفريقيا في أعقاب أحداث "11 سبتمبر/أيلول".

المصدر:الجزيرة
Published on March 14, 2014 13:58
March 8, 2014
أدب المناجاة (6): مناجاة لمجهول.
اللهم لا تسخط عليّ فأنا عبد جاهل مغلوب، وأنت العليم اللطيف الودود،
ولا تعذبني فأنا عبد ضعيف حقير، وأنت إله قوي قدير كبير،
ولا تهملني فأنا عبد محتاج إليك في كل شيء، وأنت الصمد الغني عن كل شيء،
ولا تسلبني نعمك عليّ فأنا عبد صغير فقير، وأنت رب عظيم كريم،
الله أكبر... أنا الصغير الضئيل.. والحقير الذليل..
الله أكبر.. أنا في هذا الوجود الهائل مجرد ذرة تافهة.. وفي الكون نقطة ضائعة..
اللهم أنت الحليم فتجازو عني، وأنت الرحيم فلا تعذبني لا في الدنيا ولا في الآخرة.. اللهم من يقوى على تحمل عذابك ومن يطيق إعراضك ...؟
اللهم إني أخاف أن أسقط من عينيك فلا تبالي بي، فلا تعرض عني فأنا عبدك وأنت ربي،
اللهم إني أخشى بذنوبي وتفريطي أن تكتبني في المحجوبين عنك، وهو أعظم العذاب.. اللهم إني أحوج إلى رحمتك مني إلى عقابك.. فلا تعاقبني بعدلك، بل اصفح عني برحمتك.
رب غلبتني نفسي وأهواؤها.. رب إني مغلوب فانتصر.. رب لا تكلني لنفسي طرفة عين واحدة.. رب أنقذني وأغثني..
رب إني أشهدك وأشهد جميع خلقك أنه لا إله إلا أنت، وأن نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم.. خاتم رسلك.
رب لا حول ولا قوة إلا بك.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين.
Published on March 08, 2014 06:41
إلياس بلكا's Blog
- إلياس بلكا's profile
- 50 followers
إلياس بلكا isn't a Goodreads Author
(yet),
but they
do have a blog,
so here are some recent posts imported from
their feed.