مجلة الحداثة's Blog: مجلة الحداثة - Al Hadatha Journal, page 15
May 5, 2022
مراجعات: أبو علي في "غمام الروح وتعاويذ الياسمين" - قصّاص الغيم

♦ رفيق صالح أبو غوش *
تدخل إلى نصّ محمد توفيق أبو علي** الموسوم بـ"غمام الرّوح وتعاويذ الياسمين"*** دخولاً حسّيًّا مباغتًا. ويطالعك فيه المدخل البصريّ والمدخل الذّهني. فالعتبات النصّيّة التي يقيمها تشكّل قنطرةَ العبور من المرئي إلى الميتافيزيقي، ومن الرّذاذ الذّهنيّ إلى استدعاء الخارق الباراسيكولوجي من خلال توظيف قدراتٍ خارقة للقيام بفاعليّات تتحدّى قوانين الفيزياء. أو يفتتح طقسَ روحه بتعويذةِ الياسمين قبل أن يبسطَ سهل تصوّراته مازجًا ما بين شغبِ الفصول وفتنة الطّبيعة.إن عمليّة التشاكل بين الرّؤيتين عمليّة متشابهة في طريق الدّفاع السّلبي قبل اجتياح اليباس بساط الطّبيعة. وقد مهّد الشّاعر بعتبتين متناظرتين بحيث يحمل العنوان الثّاني نزقَ الأول، ويفتح بواسطته سياق التّركيب لينأى به عن الذّبول والأفول. فالرّوح ترتبط بما هو ذهني، وتُفسَّرُ في ضوء المعرفة والسّلوك. أمّا توليفها مع الغمام فهو بحاجةٍ إلى الغيث والارتواء والكلمة الطّيبة كي تنتعشَ وتسافر في الحنين ولون الصّباح، وتطلق بوحًا عالي النّغم يهزم الواقع، ويتوق إلى النّدى على وجنات الأديم. والغمام هو السّحاب الذي لا ماء فيه، والذي يلبث في الطّبقات العليا من الجّو قريبًا من الأرض، ويهمي رذاذًا خفيفًا أنيقًا لا يؤلم الرّوح. فهل روح الشّاعر فاضت بالمشاعرِ حدّ الامتلاء لدرجة أنّها لم تعدْ تستقبل أفواج المطر، وطَرَقاتِ الماء على شبّاكها المتهالك من كثرة الحنين والشّفافية؟ أهو حفرٌ في طبقات الإيمان (ويوم تشقّق الأرض بالغمام) أو اختزال لظلٍّ يقيه حرَّ الشّمس، ويقي النّفسَ حرَّ المشاعر، فتنداح منسابةً مع الأنهار إلى أبيها البحر (وظللنا عليهم الغيم)؟هذا الرّذاذ اللّغويّ على جسد الغمام يهرع إلى المرايا التي تمتصُّ ثقلَ الرّوح، ويمسحه الشّاعر من على قميص اللّغة ليؤلّفَ حركةً تعبيريّة تتجسّد بيانًا شعريًّا جديدًا باتّجاهِ تفعيل مرآتيّة النّظرة التي تمارس شهوتها في التّحرّر والانفلات لاستيلاد متعٍ نصّيّة يحملها هذا الصّوت الثّريّ ليعيدَ تأثيثَ المفردات وإنتاج شعريّة صافية. وهو في كلّ هذا يمسك منجلهُ ليقصّ الغيمَ من فوق البحر، وليبني مكانه قصرَ البهاء على زند الموج. عرّاف الدّهشة هو من دون بخورِ اللغة. واللغة معه قصور بناتٍ على الرّمل يتركها لمجامعة الماء. يبرعمها الشّاطئ، ويهندسها طفل الموج بين أصابعه كي تخرجَ من ديمةِ الفجرِ على الورق الطّريّ حين يطلبها إلى الفراش.صادمٌ أبو علي وهو يراود الزّهرَ والنّبعَ، والزّرعَ والغيم. يأخذ إبريق المتعة ويفلفشُ صدور الكلمات بحثًا عن حمامٍ بريّ، عن نهدٍ ثريّ، عن حليب اللغة. هي رحلةٌ لحناجر الحقول في صفّ بديعٍ أنيق حيث الصّبايا يغتسلنَ برذاذ الجّمر، ويلهبنَ البذور في الأرض الخارجة من مهرجان الماكياج. وفي كلّ بذرةٍ عيدٌ ونشيد قبل أن يعبرَ قنطرة العشق إلى تعويذة الياسمين التي تمثّلُ الانعتاق والتّحرّر والنفاذ من سلطة الرّوح إلى الأمكنة الرّصينة في بياضٍ مشقوقٍ حتّى منتصف الصّدر.ففي البدايات لم تكن تعرفُ الأزهار والورود أي لونٍ عدا اللون الأبيض عندما كان كلّ شيء أبيض قبل أن يرتكبَ آدم فعلته، فيحيل الوجود إلى مشاعٍ للعابثين. وذات يوم نزلتْ أشعّة الشّمسِ وطلبت من كلّ زهرةٍ أن تنحني لتلونّها بلون خاصّ. كلّ الأزهار انحنت للشّمس إلا الياسمينة التي أبت أن تنحني، واحتفظت بلونها كما فعلت وصيفتها "ليليت" عندما تمرّدت على آدم، ورفضت أن تُخلقَ من ضلعٍ بشريّ. لذلك تُعدُّ الياسمينة رمزًا للكبرياء والتّمرّد، وتُقدَّمُ تعويذةً لحبيبةٍ متمرّدة، وتخفّف وحشة الغريب، وتبعث الأمل في النّفوس القلقة.أفلا يكون الشّاعر هو آدم الذي تمنّعت عليه "ليليت" كما تمنّعت الغمامة عن إشباعِ عطشِ الرّوح، فاستعاذَ بالياسمين ربيبة "ليليت" من يبسِ الأرض وعطشِ الرّوح! أم يكون بذلك خالفَ جاذبيّة الجسد فارتقى إلى مدار الغمام مازجًا رياح روحه بغمام الأرض الذي يتوسّلُ فراشَ الياسمين لأن يخرجه من أمسهِ إلى فضاءات الوحيّ كي يشفيَ ندوب الرّوح الهائمة في البعيد مع مجموعة تعاويذ تقيه إشعاعات نورانيّته: الأولى: ضدّ الجمال، والثّانية ضدَّ الإبداع، والثّالثة ضدَّ الياسمين؟يتداخل في نصّ أبي علي الواقع بالحلم، والأمل بتجاعيد الحياة، والنأي بعطر الياسمين، والحبّ بالأحلام المتجاوزة حدود المكان. وهي رغبةٌ في الانفلات والتّحرّر إلى سماء بعيدة تترنّق كلماتها، وتتكتّل وتتزاحم عند منعطفٍ، ثمَّ ما تلبثُ أن تنفلتَ كجلمودِ صخرٍ يحدوها شغفُ الوصول. وهي صرخةُ الواجفِ تطلقها الرّوح بقوّة الحرف، وكبرياء اللغة الطّيّعة. وهذه الرّوح التي تتوقُ إلى التكتّل في المُفارق، الملتفّ بأطياف ضوئيّة، والملوّن بغبشٍ شفيفٍ تتلاقى إشعاعاته في خطّ الزّمن الجميل.وبعيدًا من المسافة الفاصلة بين أرضٍ وسماء وأنت تغوصُ في لجّة الحرف وتستقطر الرّحيق، تباغتك الأنسامُ العليلة، وتلفّك الكلمات بوشاحٍ مغبّشٍ يليق بهذا الحضور الياسميني حين يفتح الشّعراء محفظة الياسمين فيشبّهون الشّهداء الذين يتساقطون بالياسمين (محمود درويش) والمدن التي يعشقونها بالياسمين (نزار قبّاني) والبلاد التي نزحوا منها بالياسمين (الشّعراء الأندلسيون). ويبدو لك المشهد حكاية عشقٍ أبديّ يفترّ عن بياضٍ لا حدود له. ومعه تذهبُ الصّورة إلى إيقاعٍ مائيّ يزاوج بين صنوف المعاناة. وتبدو الصّورة أكثرَ ضراوةً عندما يسحب صوت اللغة وهو يلهجُ بالمطر. فلا تكاد تخلو صفحةٌ من ذكر الغمام والمطر. ألأنّ الشّاعر يبست في عينيه الأرض كلّها فراح يستمطر الماء؟ أهو العطشُ الدّائم إلى المعرفة، أم لأن الرّوح لم تعدْ تكفيها ينابيع اللغة، أو لأن التّعاويذ لم تعدْ تداوي البؤس في هذه الأرض؟ وهو هائمٌ كالرّيح، قلقٌ كالظّن، "تعالوا نشرب قهوة الصّباح في فناجين الرّياح" (ص 75)، وهو مصابٌ وفي روحه ندوبٌ وجروح "أثخنتنا الرّيح" (ص 60)، وهو كليمٌ للرّياح "حدّثتني الرّيح"، وحديثه مع الرّيح لا يهدأ. وإذا كانت الرّيح قد أثخنته، فهل هذه هي محنة المثقّف العارف المتنبّئيّ الذي لا تسعه الصّحراء، ولا تشبعه النّساء، ولا تظلّله السّماء؟لكنّه متعبٌ، و"ليل هاجرتي طويل، أرقب ظلاً يبرّحهُ الماء، لنجمٍ يضيء فضاء الدّمع في لواعج الفقراء، لسماءٍ تمطر حبًا وقمحًا وحلمًا جميل. كرملٍ لا يجافي النّخيل، لامرأةٍ لا يغويها رجل، ولشمسٍ لا تنام في مهد الرّجال، ولريحٍ سوف تبقى للسّؤال السؤال". (ص27) هل هو التّعب يحدوه إلى التّموضع في غربةٍ بعيدة والتّمسك بعرى الياسمين انتقالٌ إلى فاعليّة نفسيّة تجمّل الوجه الآخر للعوالم المنشودة لتقولَ قولاً يتجاوز دلالته الملفوظة إلى اللّعب مع العلامة التي تحملُ الوظيفة الجماليّة. فخطابُ الهويّة الشعريّة يبحثُ في شعريّة الياسمين والتّصوّرات الذّهنيّة.قسّم الشّاعر كتابه أقسامًا ثلاثة: الشّعر والخواطر والحكايات. وجمع بين أغراضٍ ثلاثة ضمن دفّتين. لكنْ، عسى أن لا يكون قد ركب قطار التّأمّل الأخير، واستسلم لجاذبيّة العمر. وأظنّه لا يفعل. فمَن كانت قهوته في فنجانِ الرّيح، والكون في قبضة ضفيرة (ص 34)، والدّهر خادمٌ لحقوله (ص 44)، لن يغويه الشّعر المضاد للجاذبيّة، ولن يُقعده الشّاطئ عن المغامرة.ومَن يرَ في أيلول بداية الرّبيع، حين تلبس الأرض أصفرها، ويلبس الشّاعر ذاكرةً خضراء، وتفيء روحه إلى ظلّ الأغصان المتخفّفة من الثّياب الورقيّة فيجدَ فيها مخبأهُ وسلامه، ويتلو حكايات عشقه المتفتّحة، ويهرعُ إلى أمسهِ، إلى حزنٍ جميلٍ، وإلى فرحٍ مبلولٍ بالحبّ (ص 18) لن تغويه النهايات. وكل ذلك بأنويّة شعريّة غير محدودة تنفتح معها الرّوح وتنفلتُ من غمامها، وتنغمرُ برذاذ الماضي الجميل، وتتوزّع كياناتها إلى الفصول، إلى العشق والطّبيعة. فتتردّد في نصّه عبارات الغمام ومشتقّاتها: الارتواء، الظّمأ، الغيم، الهطول والجّرة وغيرها. ومفردات الطّبيعة: الياسمين، الرّياحين، البساتين، الموج والحقول. والأصوات: الهديل، الصّهيل، الصّليل والمزامير.غمام الرّوح وتعاويذ الياسمين ياسمينةٌ وارفة ساهرة في عيون الثّلج لا يسقطها صقيع، ولا تلويها رياح. وهي تعاويذُ شيخٍ في مدار اللغة. ومحمد توفيق أبو علي ذلك الشّيخ الذي أثبت أبوّتهُ اللغوية والشّعريّة، وسار في دروب السّالكين. وعوضَ أن تفتنهُ أصوات الآخرة سكنته جنّيّات الوحيّ، فأدلى بما عليه وما اكتفى.**** باحث من لبنان** محمد توفيق أبو علي : أكاديمي وأديب لبناني، أمين عام اتّحاد الكتّاب اللبنانيّين وعميد كلّيّة الآداب في الجامعة اللّبنانيّة سابقًا. له عدة مؤلّفات، منها: صورة العادات والتقاليد والقيم الجاهلية في كتب الأمثال العربية"، وضوع الياسمين*** محمد توفيق أبو علي . (2022). غمام الرّوح وتعاويذ الياسمين. بيروت: دار ناريمان للنشر
الحداثة (Al Hadatha) – س. 28 – ع. 221 – 222 - شتاء 2022 WinterISSN: 2790 -1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on May 05, 2022 13:22
مجلة الحداثة : تسعة وعشرون عامًا من التواصل
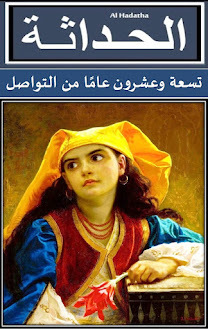
تبلغ مجلة الحداثة من العمر، مع عددها الجديد (222/221) 29 عامًا، إذ انطلقت في العام 1993 (ترخيص وزارة الاعلام 230 ت 21/9/1993) بمجهود شخصي من قبل صاحبها ورئيس تحريرها فرحان صالح، وقد شاركه في الحلم، مجموعة من الأصدقاء المثقفين والأكاديميين الحالمين مثله بمجلة تمدّ جسرًا من التواصل البنّاء بين التراث العربي العلمي والثقافي والفكري والاجتماعي والشعبي، وحداثتهم عبر مستوياتها المختلفة.هناك من يواكب المجلة منذ العدد الأول حتى اليوم، وهناك من غادرها إلا أن عينه الساهرة لا تزال ترعاها من السماء، وهناك من رأى أن أحلامه قد تغيرت وتبدلت، فتركها إلى غير مكان ...مهما يكن، وعلى الرغم من العواقب التي واجهتها المجلة، ولاسيما المادية منها، إذ توقفت غير مؤسسة وجهة عن دعمها ولم تجدد اشتراكها السنوي...، استمرت الحداثة بتحقيق حلمها، وترسيخ وجودها في المشهد الثقافي اللبناني والعربي والعالمي، عبر جهود المخلصين والحالمين مثلها، ولاسيما عبر دعم فردي من قبل شريحة من المثقفين والأكاديميين، الراغبين والمؤمنين بالمجلة، وبخطّها الثقافي، وبضرورة استمرارها.وإذ تتقدم المجلة، بالشكر لكل فرد وقف إلى جانبها، معنويًّا وماديّا، تعدهم بأنها ستبقى الحداثة المجلة الفصلية الثقافية الأكاديمية المحكّمة.
مجلة الحداثة
facebook - twitter - goodreads - instagram - linkedin
(للمزيد: المعرّفات)
صفحة الويب - صفحة الجوال

الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on May 05, 2022 11:08
الحداثة - الهيئة الاستشارية وقواعد النشر (الصفحة الأولى)
Published on May 05, 2022 10:36
March 27, 2022
مجلة الحداثة: دمج التكنولوجيا في التعليم ودور الإعلام في الأزمات - شتاء 2022

صدر العدد الجديد من مجلة الحداثة - al hadatha journal – فصلية أكاديمية محكمة (شتاء 2022 – عدد 221 - 222) تحت عنوان: دمج التكنولوجية في التعليم ودور الإعلامِ في الأزمات - أبحاث في التاريخ والآداب والاجتماع والصحة والصناعات الحرفيّة والغذائيّة.
ضم عدد المجلة التي تصدر بترخيص من وزارة الإعلام اللبنانية (230 ت 21/9/1993) – (ISSN: 2790-1785) ويرأس تحريرها فرحان صالح، عددًا من الملفات والأبحاث الأكاديمية، واستهل بافتتاحية، تحت عنوان: العربية خارج أوطانها للدكتور محمد أسعد النادري. وكتب رئيس التحرير فرحان صالح كلمة بعنوان: جابر عصفور ابن المحلة الذي جعل ذاكرتنا مقاومة للنسيان.ومن الملفات التي ضمّها العدد:ملف "في التربية والتعليم والإعلام"، وفيه: دمج التكنولوجية الحديثة في التعليم (دراسة تطبيقية لجهاز ألف باء تاء على 100 طفل لبناني وعربي( للباحثة هدى غالب مكارم . وTeachers’ Practices and Assessment of 21st century 4 Cs in grade 9 class (Brevet) in Lebanon - Heba Kamal Chami.ودورُ الإعلامِ اللبنانيّ في التّعاملِ مع الأزماتِ (نموذجُ "المنار" و"ال أم تي في" خلالَ جائحةِ كورونا) للباحث علي كامل عواضة.وشمل ملف "في التاريخ": الكعبات المقدسة وملامح نشوء فكرة الله والزمن للدكتور فرحان صالح. وأسرار المصريين القدماء - مقاربة تاريخية في المعتقد الفرعوني للدكتور عماد غملوش، ونظرية خلافة النبي (ص) في تكوين المفهوم السياسي (عند السنة والشيعة) للدكتور محمد إبراهيم قانصو. ودور الأحداث والمصادفات في تمكين هيرودس على حكم فلسطين للدكتور عماد غملوش.واحتوى ملف "في العلوم الاجتماعية": دور الصناعات الحرفيّة في بناء المجتمعات قديمًا بمحافظة مسندم (نيابة ليما أنموذجًا( للباحث محمد بن سليمان بن علي حريز الشحي. وL’IMPACT DES VALEURS SUR LES ACTIONS COLLECTIVES DES MEMBRES DU MOUVEMENT DE LA JEUNESSE ORTHODOXE - Richard Emil Rbeiz.أما ملف "في التنمية والجودة الصحية" فشمل:Small ruminant innovative product to increase resilience of vulnerable Lebanese population amid the economic crisis - Rouba Bou chalhoub & Nancy El Massih &Richard Sadaka & Maya Saadé. وAnti-COVID vaccination acceptance in Lebanon - Jad Jihad El Hage & Tania Georges Merheb .وخصص ملف "في اللغة والأدب" للأبحاث الآتية: خروج الكلام عن مقتضى الظاهر وآثاره البلاغية في تفسير "فتح البيان" لصديق خان للدكتور وليد مصطفى سروجي. والثالوث المحرم في رواية المشرط لكمال الرياحي بين الإيديولوجيا والواقع للدكتورة عائشة يوسف سنتينا. والأدب المُتَخيّر بين التعليم والتّهذيب في "العقد الفريد" لِـ"ابن عبد ربّه" للباحثة صونيا شديد غانم. والقصديّة في قصيدة جوزف حرب "الموتى" من ديوان "قلم واحد في ثلاث أصابع" للباحثة خديجة عبد الله المقداد.وأخيرًا، ضم العدد الجديد من مجلة الحداثة في باب "مراجعات" مقالة للباحث سعد محيو بعنوان: المثقفون العرب نحو "انتفاضة كبرى"سعد محيو، وحوى باب "نوافذ" قصيدة جديدة للشاعرة المصرية ديمة محمود بعنوان: "أُغنيات لا تتكرّر"يشار إلى أنه مع العدد الجديد تبلغ مجلة الحداثة 28 عامًا، إذ صدر العدد الأول في بيروت في العام 1994.الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on March 27, 2022 09:58
March 14, 2022
مراجعات : المثقفون العرب نحو "انتفاضة كبرى"

♦ سعد محيو *
"أفرزت انتفاضات 2010-2011 عدوى احتجاجات أظهرت، على الرغم من احتضار العروبة، أن المواطنين العرب ما زالوا يتشاطرون ليس لغة واحدة وثقافة واحدة فحسب، بل نوعًا من الهوية السياسية المشتركة أيضًا".لو جاء هذا الكلام على لسان مفكر أو سياسي عروبي، لأعتُبر ذلك مجرد نوستالجيا أو ثرثرة رغائبية فوق الأطلال. لكن الأمر ليس كذلك: فالمتحدث هو المركز الرئيس لصناعة القرار السياسي والفكري والقيادي في الولايات المتحدة: مجلس العلاقات الخارجية (عبر مجلة "فورين أفيرز"- عدد آذار/ نيسان 2022- ص 14).حين يُطل هؤلاء على العروبة على هذا النحو، أي إنها حيّة وتركل عبر "العدوى" في كل المنطقة العربية، على الرغم من اعتقادهم أنها كانت في "حالة احتضار"، فهذا يعني حتمًا أنهم فوجئوا تمامًا بهذا الحدث، بالقدر ذاته الذي كان هذا التطور بالنسبة إلينا بمثابة تأكيد موضوعي لما هو مؤكد: مفهوم العروبة وُجد ليبقى، وسيبقى تاريخيًّا، وثقافيًّا، وهوياتيًّا، وأيضًا سياسيًّا على الرغم من حقبة الكساد الأخلاقي والانهيارات السياسية التي تجتاح الوطن العربي من أقصاه إلى أقصاه.
حصيلة دقيقة؟أجل. لكنها خطيرة أيضًا، لأنها ترتّب على المثقفين العرب بالتحديد، وأكثر من أي فئة أخرى بما فيها النخب السياسية والدينية والاقتصادية، مسؤولية ضخمة لاطلاق مشروع وعي جديد في المنطقة يستند أولًا وأخيرًا إلى تحديث فكرة العروبة وتطويرها واستنهاضها، خاصة بعد أن أثبت انفجار المنطقة، من الهلال الخصيب إلى اليمن وشمال إفريقيا، أن أحد العوامل الرئيسة لهذا الانفجار هو غياب أو تغييب الهوية العربية الموحَّدة والموحِّدة.
لكن، عن أي عروبة تحديثية نتحدث هنا؟
ليس عن عروبة الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان والاعتراف بالخصوصيات القطرية والتكوينية لكيانات الدولة العثمانية وسايكس بيكو، والانفتاح على كل مكونات الحضارة الإسلامية والمشرقية المتوسطية فحسب، بل العروبة التي تعانق الثورات الهائلة التي تجري الآن على قدم وساق في كل أنحاء العالم أيضًا والتي ستغيّر (عبر العولمة والثورة التكنولوجية الرابعة) وجه التاريخ ومستقبل الجنس البشري على كوكب الأرض، ولن يصمد أمام تسونامياتها سوى أصحاب الهوية الحضارية المكينة والواثقة من نفسها. والحال اننا بتنا قريبين بالفعل، وللمرة الأولى في التاريخ البشري، من نقطة تحوّل "نهائية" حقيقية هذه المرة. وهذا يعني أن الهوية العربية المتجددة يجب أن تكون في آن قومية محلية وأممية عالمية، أي تعترف بقرب ولادة التاريخ الجديد وتقرر أن تكون مساهمة فيه وليس على مائدة طعامه.وهكذا، إما أن نكون عروبيين عالميين (أو أمميين)، أو لا نكون. إما أن نتجرّد من كل عدة الشغل المحلاوية السابقة في كل المجالات الثقافية، والشعورية، والاقتصادية الاجتماعية، أو نسقط من جاذبية الكرة الأرضية لنهيم في فضاء بهيم لا قرار له.العالم الذي عرفناه طيلة عشرة آلاف أو سبعة آلاف سنة يكاد ينقرض. والعالم الجديد الذي يوشك أن يحلّ مكانه لن يكون امتدادًا له، بل قطيعة عنه. لن يكون تتويجًا له، بل ربما قتلًا له:لا الزراعة ستبقى هي الزراعة، بعد أن تنتقل (وهي بدأت تنتقل) من الأرض والتربة إلى المختبرات والمعامل العلمية، ومن أيدي الفلاحين والمزارعين إلى أحضان علماء الجينات والبيوتكنولوجيا وشركات الفارماكولوجيا، ولا الصناعة بشطريها الكلاسيكي والمتطور المعلوماتي ستبقى كما هي ولن يعمّر أي نوع فيها لسنة أو أقل (هو العمر الافتراضي"الراهن" لأي جيل من أجيال العقل الالكتروني) فتحلّ مكانها صناعات أخرى أكثر تطورًا معلوماتيًّا. كما أنها ستكون هي "سيدة نفسها" فتعيد انتاج ذاتها، وتصلح أعطالها، ولن تكون في حاجة إلى "إله بشري" يخلقها أو يوجهها أو يعلّمها.لا العمل سيبقى هو القيمة، أو حتى سيبقى على قيد الحياة، ولا بالطبع العمّال، وسيكون على كارل ماركس (Karl Marx) وباقي الاقتصاديين من كل الأشكال والأنواع أن يبحثوا عن محرّك جديد للتاريخ.أما عن الحياة الاجتماعية الجديدة للبشر، فحدّث هنا ولا حرج:فالرجل، كـ"ربّ أسرة"، لن يبقى "رجلًا" ولا بالطبع "ربًّا" للأسرة، بعد أن يتم "تأنيث" العمل ونقله إلى المنزل بدل المكاتب والمصانع، جنبًا إلى جنب مع المرأة. وهذا سينسف أسس الصفقة التاريخية التي أبرمها العصر البطريركي المديد، التي يوفّر بموجبها الرجل المأكل والمشرب والمأوى للمرأة وأطفالها، فيما تقدّم هي له مقومات الحياة التناسلية والمنزلية. هذا التطوّر كان يجري على قدم وساق وإن ببطء طيلة مائتي سنة المنصرمة، مع دخول المرأة سوق العمل وتصاعد نشاط الحركات النسوية. لكنه مع التغيرات الكاسحة الجديدة في طبيعة العمل والاقتصاد والتطورات التكنولوجية، سيؤدي (وهو بدأ يؤدي) إلى تمزقات اجتماعية كبرى في جلّ المفاهيم والقيم الاجتماعية المتعلّقة بالأسرة، والعلاقات الجندرية، والقيم الأخلاقية والجنسية. لا بل حتى هذه الحصيلة تعتمد بالطبع على احتمال تمكّن الرجل من الحصول على عمل وإن منزلي وجزئي ومؤقت، إذ إن ثورات الأتمتمة وحلول البشر الآليين مكان العمّال البشر، وخسارة مئات ملايين الفلاحين والمزارعين لفرص العمل، قد يحيل قريبًا ثلاثة أرباع البشرية إلى عاطلين من العمل كليًّا أو جزئيًّا. وهنا ليس بالمستطاع قطعًا تصوّر، مجرد تصوّر، الانفجارات والأزمات الضخمة التي قد تشهدها حينذاك معظم المجتمعات البشرية على كل الصعد الاجتماعية والقيمية والصحيّة (بشطريها العضوي والنفسي)، خاصة منها عالم الدول النامية الذي يشكّل ثلثي البشرية والذي تنتمي منطقتنا إليه.إلى جانب هذه الاضطرابات الاجتماعية الكبرى، قد تبرز اضطرابات سياسية لا تقل خطورة. فعظم الدول ستكون عاجزة عن تلبية حاجات مواطنيها لمساعدتهم على التأقلم مع الانقلابات الاقتصادية- التكنولوجية الهائلة. وهذا سيحدث أولًا وأساسًا في دول العالم الأول الغربية التي شهدت منذ معاهدة وستفاليا 1648 (Peace of Westphalia) ولادة مفهوم الدولة- الأمة، التي حلّت بالتدريج مكان العناية الإلهية في توفير الأمن والغذاء ثم الرفاه لمواطنيها بهدف توفير الأيدي العاملة "الصحية" والأسواق للرأسمالية النائشة، بعد أن كانت الدولة في المجتمعات الإقطاعية السابقة تعتمد سياسة السيطرة والاخضاع بالقوة وحتى الابادات لرعاياها.الآن، ومع الفقدان المتواصل للدول- الأمم لسلطاتها وقدراتها، يُرجّح أن تعود معظم فئات العديد من مناطق العالم إلى صيغة من صيغ القرون الوسطى الخاصة بمفاهيم السيادة والأمن والاقتصاد، سواء المحلية منها أو الإقليمية، فيما تندمج قلة قليلة فيها في النظام العالمي المتعولم وتدمن على الرضاعة من ثدي العولمة بدلًا من ثدي أوطانها القومية. وحينها ستكون مفاهيم شاملة من طراز القومية وطبيعة الدين، ومعنى الحضارة، وحتى فلسفة الوجود، على بساط التشريح والشكوك العميقة، إذا لم تستطع هذه المفاهيم تطوير ركائزها وتحديث توجهاتها. وهذا ما قد يتسبّب بفوضى فكرية لم يسبق لها مثيل في التاريخ، خاصة إذا ما عجزت العولمة الرأسمالية، أو الأديان الكبرى، أو الفكر الاشتراكي- الإيكولوجي، أو العولمة البديلة عن طرح وعي كوني جديد وهوية حضارية عالمية بديلة تكون قادرة على الحلول مكان الهويات التي ستتناثر أشلاء في العالم.لكن، حتى إذا ما نشأت هذه الهوية العالمية الجديدة، فإن العلماء والأنثروبولوجيين يتوقعون نشوء هويات جديدة إلى جانبها من نوع لم يعرف التاريخ له مثيلًا من قبل، على غرار "الذات الوسطانية- Mediated – (المعتمدة على الميديا الإلكترونية)، والذات السايبورغية (Cyborg) التي هي مزيج من الإنسان والآلة، والذات المتبطّلة (غير العاملة التي تعيش على عوامل التسلية)، والذات الافتراضية (التي تعتاش على الحقيقة الافتراضية)، والذات المتحوّلة (حيث تغيّر جينات الفرد قبل أن يولد)، وبالطبع الذاتيات الطائفية المذهبية والإثنية العتيقة التي قد تستخرج من القبر.هنا يدخل الذكاء الاصطناعي (Artificial intelligence- AI) على الخط ليستكمل اقتحام التكنولوجيا لكل مجالات الحياة البشرية، وليُحدث تحوّلات تاريخية ضخمة في المجتمع والاقتصاد والسياسة العامة والسياسات الخارجية، بشكل يتجاوز قدرة أي مفكر أو باحث أو سياسي محترف بمفرده على إدراك ما يجري أو مجرد الإحاطة به.
الذكاء الاصطناعيتعريفًا، ليس صناعة أو منتجًا منفردًا، بل هو أشبه بموجة عاتية تخترق العديد من الصناعات وأوجه الحياة الإنسانية: من البحث العلمي والتعليم والثقافي والفن إلى التصنيع واللوجستيات والنقل والدفاع وتطبيق القانون والإعلانات والحروب السيبرانية. وهو بسبب ما يتميّز به من التعلّم الذاتي، والتطور السريع، والمفاجآت، سيكون قادرًا على تغيير الهوية البشرية نفسها ومعها فهم الإنسان لطبيعة الحقيقة الموضوعية على مستويات لم نختبرها منذ فجر العصر الحديث، خاصة بعد أن أعلن عمناويل كانط (Immanuel Kant) وكوكبة أخرى من الفلاسفة الحديثين (كما الأقدمين) عجز العقل البشري ذي الأبعاد الثلاثة عن إدراك كنه "الشيء في ذاته" أو الحقيقة الموضوعية.بكلمات أوضح: الذكاء الأصطناعي سيكون قادرًا، بعد التطوير القريب للكومبيوتر الكمي وكومبيوتر الحمض النووي، على تقديم صورة للعالم الخارجي من شأنها قلب مفاهيم البشر ومدركاتهم عن الحقيقة رأسًا على عقب. وحينها قد يكون هناك حقًا "نهاية للتاريخ".
أي تاريخ؟بالطبع، تاريخ البشر الذي يخشى الآن العديد من الباحثين أن يصبح جنسًا "لاغيًا ومندثرًا" ذهب ريحه وانتهى دوره على كوكب الأرض.بيد أن عمليات الانقطاع التاريخي هذه لن تتوقف هنا. فإلى جانب الانقلابات الشاملة، اجتماعيًّا واقتصاديًّا وفكريًّا وقيميًّا، سيكون هناك تطور أخطر بكثير وأقرب إلى الزلزال منه إلى الانقلاب، وهو تحرّك العلم والتكنولوجيا، أساسًا عبر هندسة الجينات والبيوتكنولوجيا أو التكنولوجيا الحيوية، نحو تغيير طبيعة الإنسان نفسه.هذا المشروع، الذي يعمل الآن من أجله كم هائل من الدول والشركات والعلماء والمنظمات السرّية وغير السريّة، يستند إلى فكرة بسيطة للغاية وواضحة للغاية: تطوّر الإنسان وفق قانون الانتخاب الطبيعي الدارويني، يحتاج إلى ردح طويل من الزمن. لكن الآن ومع التقدم الهائل للعلم والتكنولوجيا، بات بإمكان الإنسان أن يتحكّم للمرة الأولى في التاريخ بعملية تطوره الخاص، بدلأ من انتظار الانتخاب الطبيعي البطيء الذي توقف أساسًا لدى الإنسان بسبب انتهاء مراحل العزلة لدى البشر والتي هي الشرط الرئيس للتحولات التطورية.
لكن كيف ستتم عملية التطوير الذاتية؟
ليس من خلال القيم العليا والفلسفات الروحانية التي يمكن أن ترتقي بالوعي البشري من الوعي الماكيافيلي الموروث من العصور الحجرية والقائم على صراع البقاء وحرب الجميع ضد الجميع، بل عبر تزويج خليّة السليكون بالخليّة الحيّة، والميت بالحي، والمادي بالعضوي، وبالتالي استيلاد مخلوقات جديدة تُدعى السايبورغ (Cyborg) التي ألمعنا إليها أعلاه: نصف آلة ونصف إنسان. مثل هذه المخلوقات ستكون فائقة الذكاء، بسبب تقاطع قدرات العقل البشري مع إمكانات العقل الإلكتروني اللذين سيندمجان ببعضهما البعض، مما سيجعل هذه الكائنات أشبه بآلهة الإغريق، أو هي ستتحوّل إلى ذكاء رقمي يسبح في الفضاء السيبراني وفي كل الكون، أو تكون قادرة على البقاء على قيد الحياة طويلًا بصحة كاملة، إن لم يكن إلى الأبد.أرباب العولمة الرأسمالية يرسمون صورة زاهية لعالم جديد تقوده التكنولوجيا نحو البحبوحة والتطور السريع والولوج إلى عوالم قد لا تخطر على بال. لكن في مقابل هذه الصورة الزاهية والجميلة، يرسم نقاد العولمة الرأسمالية والتكنولوجيا المنفلتة من عقالها من دون ضوابط إنسانية- أخلاقية وتنظيمات قانونية جديدة، صورة مغايرة تمامًا.يقول هؤلاء إن السيطرة الفعلية للآلات على حياة البشر، كما يحدث الآن، يعني إخضاع الجنس البشري إلى النزعة المادية المطلقة التي سبّبت طيلة القرون الخمسة الماضية سلسلة الكوارث المفجعة في التاريخ البشري، من الابادات الجماعية والحروب العالمية المتواصلة، إلى وقف تطور مسيرة الضمير، والأخلاق، والقيم الروحانية المتسامية (التي تعني هنا وحدة الوجود وكل الكائنات). وعلى الرغم من أن هؤلاء النقاد لا ينفون إيجابيات هذه النزعة المادية، بخاصة في مجالات التطور العلمي وبروز مفاهيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، إلا أنهم يحذرون من أن هذه المكاسب باتت كلها عرضة إلى التقويض بفعل الصعود الكاسح لرأسمالية عالمية يدمغونها بالتوحش.هذا التخوّف لا يقتصر على التيارات اليسارية والديمقراطية والبيئية، بل هو يجري أيضًا على ألسنة عتاة الفكر الرأسمالي الذين يُعدّون "الجناح المتنوّر" في المعسكر الرأسمالي.فها هو، مثلًا، كلاوس شفاب (Klaus Schwab)، مؤسس المنتدى الإقليمي العالمي (أهم ملتقى تخطيطي وفكري للعولمة التكنو- رأسمالية) يرفض في كتابه الأخير: "السردية الكبرى" ما أسماه “عقلية يوم الآخرة التي تحيل البشر إلى مستقبل اندثاري وانقراضي"، لكنه يسجل في الوقت نفسه المخاوف الآتية:- مخاطر تسارع الأتمتة والروبطة والابتكار، وتفاقم التفاوت وعدم المساواة، وتزايد سلطة التكنولوجيا والتجسس، والتراجع النسبي عن العولمة، والتفكك المتزايد للمشهد الجيوسياسي، وتآكل البيئة، والأوبئة، والجرائم السيبرانية.- وباء كوفيد جاء في وقت كانت اقتصاداتنا ومجتمعاتنا غير مؤهلة لمجابهة التحديات التي برزت أمامنا، حيث المشهد الجيوسياسي والتكنولوجي يعاد تشكيله بطريقة ستجعلهما غير مفهومين لنا خلال حفنة سنوات، وحيث بيئة الأرض على شفير كارثة بات معها تغير المناخ خطرًا وجوديًّا، وحيث الأزمات على أنواعها تنفجر كلها دفعة واحدة ما يجعل الحقبة الراهنة من التاريخ فريدة من نوعها.بيد أن كل هذه الأزمات بالنسبة إلى شفاب هي مجرد "مفعول به" يفتقد إلى "فاعل". وحين يأتي دور هذا الفاعل، وهو بالطبع التكنو- رأسمالية، يعترف بأن الطبقة الرأسمالية لن تكون بأي حال مستعدة لإنقاذ الحياة على كوكب الأرض من التدهور البيئي، لأن الانتقال من اقتصاد الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة سيكلف ما بين 100 إلى 300 تريليون دولار. وبالتالي، فهو يدعو الحكومات، أي دافعي الضرائب، إلى تحمّل هذه التكلفة وحدهم. وكما في مجال البيئة، كذلك في مسألة اللامساواة العالمية. فشفاب يعترف بأن العولمة زادت ثروات الـ1% الممسكين بزمام الثروات والسلطة والمعرفة، فيما ثلاثة أرباع البشر يرتعون أكثر في لجج الفقر. ومرة أخرى، الفاعل هنا مجهول، والمخرج يحال إلى صيغة ضبابية حملت الشعار الفضفاض "إعادة صياغة العقد الاجتماعي بين الحكام والمحكومين".أما بالنسبة إلى التكنولوجيا، خاصة في مجالي الذكاء الاصطناعي والبيوتكنولوجيا اللذين يمسك بكل تلابيبهما طبقة الواحد في المئة الرأسمالية، فلا يجد شفاب حلًا سوى التحذير من أن غياب الضوابط القانونية والأخلاقية "سيدفع بالجنس البشري إلى سباق تسلّح جيني (ورقمي) قاتل".صاحب "نهاية التاريخ" فوكوياما (Fukuyama)، وعلى الرغم من إيمانه المطلق بالمادية الرأسمالية الغربية الصلدة، لم يسعه تجنّب الإفصاح عن رعبه وهو يتابع تطور حركة الترانس هيومان (ما بعد الإنسان):"لا أحد يعرف أي "احتمالات تكنولوجية ستنبثق من التعديل الذاتي للجنس البشري. لكن الحركة البيئية على حقّ حين تعلّمنا ضرورة التواضع واحترام وحدة الطبيعة. نحن في حاجة الآن بالفعل الى تواضع مماثل في ما يتعلق بالطبيعة البشرية. وما لم نفعل، سنكون قد أفسحنا في المجال أمام ما بعد الإنسانيين (الترانس هيومان) لتشويه البشرية ومسخها بجرافاتهم الجينية".هذه بعض ملامح العالم الجديد، عالم الانقطاع التاريخي إذا جاز التعبير، الذي بدأ يولد تحت أعيننا مباشرة الآن. وهو كما أسلفنا، عالم لن يبقى فيها على قيد الحياة سوى أصحاب الهوية الحضارية المتطورة القادرة وحدها على الصمود والمشاركة في صياغة عالم جديد يفترض أن يكون متعدد الحضارات (بعد التراجع المتواصل للسيطرة الغربية على العالم وصعود نجم الحضارات القديمة في شرق آسيا وجنوبها).بالطبع، لن يستطيع فرد واحد أو حتى مجموعة محدودة من المفكرين العرب صياغة هذا الرد الحضاري الكبير، بل سيحتاج الأمر بالفعل إلى بلورة "عقل جماعي عربي" يعانق عصر الذكاء الاصطناعي والعولمة، في الوقت ذاته الذي يعيد فيه بناء الصرح الوطني العربي على أسس جديدة وحديثة.
هاكم هنا بعض الأفكار:
- تحويل هيئة الحوار العتيدة بين المثقفين العرب إلى مؤسسة رسمية دائمة لها فروع في كل الوطن العربي، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية وباقي الهيئات الإقليمية والمجتمعات المدنية العربية.- تعمل هذه المؤسسة على تحرير المثقف العربي الحر من شتى القيود التي تكبّل حركته واستقلاليته، كي يستطيع وضع فكره وممارسته في خدمة قضية العروبة الجديدة. ومثل هذه المهمة الجليلة تتطلّب بذل كل الجهود مع كل/ وأي طرف أو مؤسسة في الوطن العربي ملتزمة بمسألتي الهوية والنهضة العربيين.- يكون على رأس مهام مؤسسة حوار المثقفين نشر الوعي بين المواطنين العرب حول الحقيقة بأن غياب أو تغييب العروبة بكل مندرجاتها الحضارية والاستراتيجية كان أحد الأسباب الرئيسة للكوارث التي حلّت بالأقطار العربية وأدّت في خاتمة المطاف إلى شرذمتها طائفيًّا ومذهبيًّا، ما سمح للمباضع الدولية والإقليمية بالتدخل لبسط سطوتها ونفوذها.- كذلك، ينبغي التوضيح أن استنهاض العروبة مجددًا على كل الصعد الحضارية والاستراتيجية والاقتصادية، لا يعني البتة عدّ الكيانات الأخرى للحضارة الإسلامية، من أكراد وأتراك وإيرانيين وغيرهم، هم الضد أو الأعداء الذي تتشكّل الهوية العروبية على أساس العداء لهم، بل العكس هو الصحيح: حيث سيكون من مصلحة العروبة الجديدة إعادة بناء نظام إقليمي جديد في المشرق المتوسطي على قدم المساواة بين كل مكوناته وعلى أسس الديمقراطية والتعاون الخلاق والحريات العامة.- العمل على نشر الوعي بين المواطنين العرب حول حقيقة أخرى، هي أن مشروع التكامل العروبي هو المدخل الوحيد أمام كل العرب لولوج عصر الذكاء الاصطناعي والتوحّد الاقتصادي العالمي، وإلا سيكون 400 مليون عربي على لائحة التهميش النهائي وربما حتى أيضًا الإبادة الحضارية والجسدية.- العمل على طرح حلول لـ"المسألة اليهودية" في إطار البوتقة العروبية الحضارية الجديدة، كبديل من العنصرية الصهيونية، وكمدخل لاستعادة كل فلسطين إلى الحضن العروبي.- سيكون على رأس الأولويات أيضًا قيام المثقفين العرب بحملات واسعة النطاق لتوضيح مخاطر تغيّر المناخ وتلوث البيئة، وضرورة العمل من الآن على إيجاد مخارج وحلول لها، بالتعاون مع كلٍّ من الشعوب الإقليمية المجاورة كما مع الأطراف المنتمية للحضارة المتوسطية في جنوب أوروبا.ختامًا، أمام المثقفين العرب قاطبة مهمة تاريخية ضخمة وجليلة في هذه المرحلة الفاصلة من التاريخ البشري، كما من تاريخ ثقافتنا وحضارتنا. والخطوة الأولى للقيام بهذه المهمة هي استعادة الثقة بأنفسنا وهويتنا وتاريخنا ودورنا الريادي التي تجسدها كلها فكرة العروبة الجامعة، تلك الفكرة التي اعترف حتى أعداؤها في مجلس العلاقات الخارجية الأميركية، بأنها لا تزال تنبض بالحياة والحيوية، وتنتظر الآن من يعيد رفع رايتها خفاقة في أرجاء وطننا العربي.**** كاتب لبناني
الحداثة (Al Hadatha) – س. 28 – ع. 221 – 222 - شتاء 2022 WinterISSN: 2790 -1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on March 14, 2022 09:04
نظرية خلافة النبي (ص) في تكوين المفهوم السياسي (عند السنة والشيعة)

♦ محمد إبراهيم قانصو *
- نبذة عن البحث
تهدف الدراسة إلى إبراز نظرتين في قضية خلافة النبي وإمامة المسلمين، وهما: نظرية الاختيار أو الشورى، ونظرية النصّ أو التعين، لذا تحاول هذه الدراسة طي صفحة هذه القضية من الناحية التاريخية، ومعالجتها بموضوعية وشفافية، لأنها قضية حاضرة في حياة الإنسان المسلم، ويعيش انعكاساتها السلبية، من حروب أهلية ومشاكل لا طائل من ورائها سوى الخراب وبعثرة الجهود. وقد حاول الفريقان إثبات أحقية موقفه وأدلى بما لديه من حجج وأدلة، من دون أن يؤدي ذلك إلى نتيجة عملية محسومة، ولم يُتفق على نظرية واحدة.اُعتمد في هذه الدراسة على المنهج التاريخي الاستدلالي والاستردادي والمنهج الفلسفي القائم على التحليل والتركيب مع مزج لبعض المناهج من استقراء واستنباط وفق ما تدعو إليه الحاجة.وتخلص الدراسة إلى نتيجة مفادها أن التقارب بين المذاهب هو السبيل الوحيد لإزالة الشبهات، وأن المصارحة هي أفضل الطرق نحو المصالحة في فهم جوهر الدين بعد الصحوة الإسلامية القائمة على أسس أيديولوجية تحرك القوى السياسية. وتقدم الدراسة بعض الاقتراحات والتوصيات التي تدعو إلى إعادة تصحيح التاريخ بناء على معايير محددة، وإعادة استنباط أحكام صحيحة من المصادر الحقيقية (القرآن والسنة) وتعشيب الأحاديث في معظم الكتب والسير والتواريخ. والعمل على التقريب بين المذاهب وفق رؤية إسلامية موحدة وتوحيد الكلمة حول رسالة التوحيد التي هي مطلب منطقي لجميع المسلمين واستكشافها من مصادر الإسلام بعيدًا من السياسة. مع حفظ الحريات الإقليمية والمذهبية التي تتمثل في: الدفاع والتنمية، والمحافظة على الثقافة الإسلامية.
الكلمات المفاتيح: الخلافة، الإمامة، الشورى، النص والتعيين، الاستخلاف**** دكتوراه في العلوم سياسية والعلاقات دولية - أستاذ محاضر في الجامعة الإسلامية في لبنان
المصادر والمراجع
· القرآن الكريم
1- ابن منظور، لسان العرب2- البحراني، الشيخ يوسف (1999)، التأويل منهج الاستنباط في الإسلام، دار التأويل للطباعة والنشر ط.23- البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، دار القلم – بيروت لا. ت. لا.ط4- حسين، الشيخ محمد (1377 هـ -1958)، كاشف الغطاء، أصل الشيعة وأصولها، مكتبة النجاح، ط.15- شرف الدين، عبد الحسين، المراجعات. مؤسسة الوفاء، بيروت، لات، لاط6- الشهرستاني، أبو الفتح، الملل والنحل، مؤسسة الحلبي7- الصدر، السيد محمد باقر الصدر (1399 هـ - 1979م) بحث حول الولاية، دار التعارف للمطبوعات، بيروت8- العسكري، السيد مرتضى (1410 هـ -1990) معالم المدرستين، بحوث معدة لتوحيد كلمة المسلمين، مؤسسة العثمان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت9- الغريفي، عبد الله، (1417 – 1997) التشيّع، نشوؤه، مرحلته ومقوماته، دار الملك، بيروت، ط.510- الكليني، (1405–1985) أصول الكافي، دار الأضواء11- المظفر، محمد حسين (1951 ص 13) المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف12- المفيد، الشيخ (1414 هـ -1993) النكت الاعتقادية، دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط.213- المفيد، الشيخ (1414 هـ -1993م) أوائل المقالات في المذاهب والمختارات، دار المفيد للطباعة، بيروت14- اليعقوبي (تاريخ اليعقوبي). مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت
الحداثة (Al Hadatha) – س. 28 – ع. 221 – 222 - شتاء 2022 WinterISSN: 2790 -1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on March 14, 2022 08:33
الكعبات المقدسة وملامح نشوء فكرة الله والزمن

♦ فرحان صالح *
تفنن الفراعنة في بناء المعابد، وكانت تجربتهم هي خلاصة الموروثات الدينية التي تواصلت وتناسخت عبر التاريخ، كذلك تكاملت هذه التجربة الحضارية الفرعونية مع تجربة وادي الرافدين، وإن تأخرت هذه التجربة الحضارية عن مثيلتها المصرية لعوامل طبيعية معينة.لقد تميزت جغرافية التربة البابلية بمواصفات لم تعرفها التربة المصرية، فتربة بابل لم تكن أراضيها مهيئة لسد حاجات السكان من المواد الزراعية. كان ذلك بسبب كثرة المستنقعات في سهول بابل التي تأخر جفافها إلى عدة قرون، وهذا ما دفع المؤرخين إلى القول بأسبقية الحضارة المصرية عن مثيلتها العراقية؛ فوادي النيل عرف نهضة زراعية مبكرة، حيث توفرت الحاجات من المواد الزراعية على تنوعها، كذلك الأخشاب والصخور والنحاس ونبات البابيروس الذي صُنعت أوراق البردى منه. كل هذا التطور ساعد على نشوء المدن في مصر، خاصة حول مياه النيل. أما في العراق فقد تنوعت الأجناس البشرية التي كانت تأتي من أماكن متعدده. في حين أن مصر لم تكن تعرف هذه الظاهره سوى في فترات متأخرة.لقد ساعد كل ذلك مصر على إدارة شؤونها بنفسها، كذلك سهل وحدتها السياسية التي كان نشوء المدن من أبرز معالمها، في حين إن هذا التطور لم تعرفه الطبيعة الجغرافية لوادي الرافدين، ما أدى إلى تأخر حضورها الحضاري عن مصر لمئات السنين. ففي مصر كذلك في العراق، كانت قد فاضت مياه النيل، ومياه دجلة والفرات، وإن كان ذلك قد حصل مبكرًا في مصر، ومتأخرًا في العراق كما يرى علماء الجيولوجيه. وهذا ما حوّل أراضي كل منهما إلى مستنقعات، ومن بعد جفاف المياه الذي استمر لعقود من الزمن، نمت الأعشاب واُستثمرت الأرض بزراعتها وتشجيرها ما ساعد مصر، قبل ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد على الاستقرار، وتمتع مجتمعها بالوحدة والسلام، بعكس بابل التي تأخر جفاف المستنقعات لعدة قرون، وأدى إلى التأخر في استغلال بيئتها زراعيًّا، فضلاً عمّا عانته بلاد الرافدين من الحروب الأهلية والغزوات الخارجية.في هذين البلدين قامت أقدم وأرقى الحضارات التي استندت عليها جميع الحضارات القديمة؛ فمن مصر أخذ الإغريق علم الهندسة والتشريع والفلسفة وفكرة نشوء الزمن، ومن الفينيقيين أخذوا الأبجدية، ومن بلاد الرافدين علم الفلك... فكانت الإمبراطورية المصرية تمتد من النوبة حتى كركميش (جرابلس) والأمبراطورية الأشورية تمتد من بلاد فارس حتى وادي النيل.
- آلهة الكعبات المقدسةانتشرت المعطيات الحضارية القديمة لمصر والعراق في غير مكان؛ فالأديان في أول نشأتها، اهتمت بنشر قوانين الأدب والأخلاق، وهدف تلك القوانين والنواميس تطويع الإنسان وتدجينه والعمل عل تكيفه ظاهريًّا أمام إله أعلى، وعمليًّا استلاب حريته، وخضوعه لزعيم القبيلة أو غيره من زعماء. ففي الجزيرة العربية، قلّدت القبائل المنتشرة هناك هاتين التجربتين المتشابهتين في الشكل والمضمون، وإن كانت كل منهما قد رسمت صورًا للقبة السماوية ذات الأسقف المتحركة والشبيهة بخريطة السماء الفلكية المتغيرة... لقد انتقلت هذه الرسوم عبر القبائل إلى الجزيرة وغيرها، حاملة اعتقادًا من أن ما أوجدوه على الأرض هو ذاته المتشابه مع ما عليه ببيوت الآلهة في السماء، فبنوا على الأرض ما اعتقدوا أنه في السماء. هذا النسق المفتوح على الجهات الأربع، كان الهدف من بنائه رصد الأجرام السماوية ومراقبتها.لقد انتشرت هذه البيوت التي سميت في الجزيرة العربية بـ"الكعبات" تلك البيوت التي انتشرت قبل القرن السابع الميلادي، وكانت كعبة مكة التي قيل إن النبي إبراهيم هو من بناها، نموذجًا لما رسمته واحتوته ديانات عصرها، أي نحو ثلاثمائة وخمس وستين تمثالا ورمزًا دينيًّا، وكانت في شكلها، قريبة عمّا هي عليه بيوت الآلهة في المشرق، لكنها متميزة عمّا هي عليه في مصر.احتوت كعبة مكة على تماثيل للنبي إبراهيم، والمسيح والعذراء، أيضًا لللآت والعزى ومناة وغير ذلك من رموز دينية معروفة ومنتشرة في ذاك الزمن. وكانت الرموز المسيحية الأكثر حضورًا وانتشارًا، بسبب أن مكة بالإضافة لنجران كانتا من أبرز المدن التي انتشرت فيها الديانة المسيحية.مثّلت هذه الكعبات مركز جذب وتجمع قبلي ديني، وإن كانت في أصولها الأولى تدار من آلهة من النسوة. وكانت الفرق المنتشرة التي تدين بالعقيدتين اليهودية والمسيحية ذات سطوة وحضور في الجزيرة، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال تمجيد الشعراء المسيحيين للعذراء والمسيح، كذلك تمجيدهم اللات والعزة ومناة وغيرها من معبودات تجسدت رموزها في هذه الكعبات التي كانت أمكنة لرموز دينية تمثل تعددية المعتقدات القبلية، وبالتالي الروح الإلهية التي تعبدها وتدين بها قبائل الجزيرة العربية واليمن، ومن أبرز هذه الكعبات:- كعبة مأرب، وهي الأشهر، كان لها أبواب تفتح وتغلق في مواعيد معينة.- كعبة "ذي الشري" عرفت في مدينة البطراء، وكان يقدسها العرب.- كعبة بُني في ساحتها تمثالان لأسدين من البرونز، يمتطيهما طفلان.- كعبة نجران التي أسسها مسيحيون، تمت تسميتها باسم الربّة.كما وجدت كعبة سميت باسم العزى وأخرى باسم الشامية وغمدان، وغيرها العشرات من الكعبات التي انتشرت في أمكنة مختلفة، وكان لكل قبيلة أو أكثر، كعبة تجتمع وتتحاور فيها مع إلهها الحامي لها.حملت هذه المعتقدات بتنوعها، إيمانًا بإله يذوب بالوجود الكوني، ولا انفصام بينه وبين موجودات هذا الكون، فكل ما في هذا الكون محض تجليات لهذا الإله. لذا عبرت هذه الكعبات بما احتوته، على هذا الشعور المعتقدي المنتشر في حضارتي مصر ووادي الرافدين.الله كيان متدفق ومتغير، وقد عبرت عن ذلك تلك التنوعات المنتشرة في هذه الكعبات، أي 365 رمزًا وتمثالًا، هذه التي كانت متصالحة مع إلهها ومع ما تؤمن به وتعتقده، فالمعتقد الديني القديم، ورث ما بنته شراكة أمّنا حواء وأبينا آدم في رؤيتيهما لكيفية بناء عالمهما. حصل ذلك بعد انفصالهما عن العالم الحيواني الأول. لقد تغلبت في البدء، المساحة الأنثوية على ما عداها، ومن ثم بعد تدجين آدم من قبل حواء واستقرارهما معًا، برزت النزعة العقدية التي تصالحت مع تقدم الزمن مع إله، تساوت فيه المساحة الأنثويه مع المساحة الذكورية. فتصالحت بهذه المصالحة الكائنات جميعها، وعبرت عن هذه المصالحة "الكعبات" التي لم يميز المشرفون عليها، بين موجودات الطبيعة من ذكر وأنثى، أو شجرة وطير وحيوان وغير ذلك من كائنات.لقد وجدت في تلك الكعبات كل الرموز التي تمت عباداتها والتي تمثل كل موجودات الطبيعة؛ فاللات مثلًا رمزت للبعض، بالشمس، وكان التجلي الأول لفكرة الإله بطبعته الأولى، وكانت أيضًا التجلي الأول لفكرة الإلهة الأنثوية، فتعبير الله ذاته انبثق من اسم اللات، والله ذاته في طبعته الأولى كان ابنًا للات، إلا أنه عندما كبرت مكانته أصبح زوجًا لها. هذا هو الاعتقاد الأول، لقد كانت الآلهة الأولى القديمة جميعها من النساء الناطقات باسم الغيب. وعرف منها في وقت متأخر: الزبّاء والكاهنة وسلمى الهمدانية وسجاح وغيرهن الكثيرات.وكانت كعبة الله بمكة أيضّا بالطائف ونجران، عنوانًا لتلك العبادات التي انتشرت في معظمها في نهاية العصر المطريركي واستمرت حتى ظهور المشروع المحمدي. لقد سمي الصبح على سبيل المثال، ابنًا للات، لأنه من ضوئها، وسُمي الحجر الأسود الذي يتدافع المسلمون على لمسه، بالحجر المقدس، حيث ارتبط اسمه باللات وقُدّس اعتقادًا بأنه سقط من السماء... السماء التي كان ينظر إليها أنها جدار صلب يحبس الماء الذي يتدفق ويغمر السماء والأرض. لقد عُدّ الحجر الأسود بأنه مساحة سقطت من السماء على الأرض، ومن هنا جاءت قداسته.تعممت عبادة اللات، لكن عندما جاء محمد بمشروعه الديني، أمر بهدم كعبة اللات، مع أنه حينما حطّم الأصنام الموجودة في مكة، احتفظ بتمثالي السيدة مريم وعيسى المسيح، والملاحظ أنه بعد تدمير كعبة اللات (أم الإلهة) أخذت النذور منها وهي أكداس من الذهب والفضة وغير ذلك، وأمر محمد باعطائها إلى أبي سفيان بن حرب. هذا ولم تكن صورة العزى ومناة وغيرهما أقل مكانة وحضور من اللات، بل كانت لكل واحدة منها مكانتها عند القبيلة التي تعتقد بمعجزاتها؛ فللعزى تمثالان عظيمان من ذهب، وكان يطوف حولهما المريدون، وخصصت لها مساحة واسعة من الحمى الأرض، أي الحرم المقدس، حيث حرم فيها الصيد والاعتداء. وهكذا بالنسبة إلى الكعبات الأخرى، وكان الحرم مساحة يجتمع فيها المتخاصمون من القبائل للحوار والتفاهم.شكلت كل من هذه المعبودات مساحة من مساحات الأنوثة الكونية. وكانت قبائل قريش وكنانة وغيرهما تعظم العزى التي انتشرت عباداتها في بصرى الشام، وفسّر بعض المستشرقين هذه الظاهرة، بأن اللات والعزى كانتا ترمزان عند الأقدمين إلى كوكبي الصباح والمساء.لكن حين جاء المشروع الإسلامي، تبدلت العادات والتقاليد، وتبدلت وظيفة المعابد وبدأ عصر جديد، خرجت المرأة من التاريخ، ومن دائرة القيمة التي كانت تتمتع فيها.كانت تلك الكعبات ملاذًا لعبادات القبائل والحج إليها، وكان لكل منها وظيفة بمثابة مؤسسة علمية للرصد الفلكي، فمنها كان يتابع دوران النجوم والأفلاك حول عرش الله، العرش الذي يحمله ثمانية من الملائكة. كما روّج لذلك الإبراهيميون التي اختلفت نظرتهم العقدية عمّن سبقهم، فوظيفة الكعبات في الحضارتين الفرعونية ووادي الرافدين، مكان أو بقعة مقدسة تدار من خلالها منظومة الوجود المرتبطة بضبط التقويم السنوي، أو ضبط قياس حركة الأفلاك، وبالتالي حركة الزمن الإلهي.هناك رواية حول بناء الكعبة، فالله خلق موضعها حسب الرواية الإسلامية، قبل أن يخلق شيئًا من الأرض بألفي عام. وإن الله بعث الملائكة وقال: ابنوا لي في الأرض بيتًا، فلمّا جاء الطوفان في عهد نوح، رفعه الله (أي البيت الكعبة) إلى السماء الرابعة، وأخذ جبريل الحجر الأسود الذي هو هدية السماء إلى الأرض، وقد وهبه الله إلى إبراهيم يوم بنى الكعبة، ووضعه في الجبل مقابل مكة، خوفًا عليه من الغرق، فكان البيت هو بيت إبراهيم. فلما ولد إسماعيل أمره الله ببناء بيت يتم ذكره فيه، فقال يا رب بيتي صنعته. فأرسل الله صورة للكعبة فوضعت في موضع البيت، ونودي يا إبراهيم ابن على ظلها، لا تزد، لا تنقص، فكان جبريل يعلمه وإبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، ثم إن جبريل قصد جبل أبي قبيس، فاستخرج الحجر الأسود منه وأعطاه لإبراهيم فصار حجر الزاوية في البناء... هذه هي الرواية الإسلامية حول كيفية نشوء الكعبات المقدسة.
- النسئ وتحريمه حّرم الإسلام النسئ، وحذر من تعميم التعاليم المصرية التي رسمت لكيفية نشوء الزمن، فالنسئ الذي حذر منه في "سورة التوبة : 37": ﴿ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾، يبدو أنه قُصد منه الأيام المنسية في التقويم السنوي الفرعوني، أي الأيام التي أضافها النساؤون إلى التقويم الزمني حتى ينضبط. وكانت ملاحظاتهم مرتبطة بمراقبتهم لتدفق حركة مياه النيل، أو ما كانوا يسمونه حركة مياه الجنة، تلك التي يتم رصدها لحظة شروق الشمس صباحًا وكانت تظهر بظهور النجم اليماني الشعرى مرة واحدة في السنة، وكان هذا النجم يسهل رصده وتحديد طوله ودورته، وصولاً لتحديد السنة الشمسية التي قسموها 12 شهرًا، أي انهم حددوا مجموع أيام السنة بـ360 يومًا، ثم لاحظوا أن الشعرى اليماني يتخلف عن ميعاده خمسة أيام كل عام، وقد سموها الأيام المنسية، أو النسئ، وأضافوا إلى الأيام المنسية يومًا سادسًا كل أربع سنوات، سموه يوم أوزوريس، وهكذا أصبحت السنة المصرية 365 ليضيفوا أيضا كل أربع سنوات يومًا أي خمس ساعات و499 دقيقة.بهذه الدقة رسم الفراعنة رؤيتهم للزمن الذي تأخذ به البشرية اليوم. لقد ولّدت الأيام المنسيّة في الذاكرة الشعبية المصرية، أشكالاً متنوعة للإله ووظيفته:الصورة الأولى لـ"رع" الذي خاطب الأشمونيين قائلاً لهم: أنا الإله الذي خلق نفسه. والثانية لـ"نو" الذي صنع اسمه ليتكوّن من جماعة الآلهة، إله. والثالثة لايزيس التي كانت رمزًا للخير، والرابعة لأوزوريس رمز الخصوبة، والخامسة لسيام رمز الشر. والسادسة لنفتنيس رمز البركة...ورأى العلامة محمد حسين هيكل في هذا التدرج، أنه لا بدّ أن تكون لأسماء الآلهة مدلولات رمزية أو لغوية تعبر تعبيرًا صحيحًا عن حكمة وعلم خالصين لا تشوبهما أية شائبة تضعف من قدرهما. وتتبين هذه الحكمة عند الفراعنة من مراقبتهم للأفلاك السماوية واكتشافهم للشعرى اليماني الذي قدّسوه بحسبانه الأساس الذي ساعدهم في الوصول لرسم معالم النظام الفلكي كله، وعبره اكتشف الفراعنة حساب دورة الزمن الذي عبر مراقبته، وضعوا نظريتهم حول تشكل الزمن ونشوئه.بهذا الاختراع تحولت البشرية من مجرد قطعان من الحيوانات إلى كيانات بشرية تتحرك داخل إطار منظومة حسابية ثابتة سموها الزمن. ويلحظ هيكل أن قدماء المصريين استغلوا قوى الطبيعة عن طريق العلم بخير مما استغلها من خلفهم من سائر الأمم، ويتبين من خلال النصوص، أنهم بلغوا في بعض الأحيان، مدى لم تبلغه الإنسانية الحاضرة.ويضيف هيكل: يوم كانت مدنية الفراعنة قائمة، كان اليونانيون يغترفون من علوم مصر ومن حضارتها، وكانوا على أوثق الاتصال بها. كذلك ذهب أحمد باشا كمال إلى نظرية في أصل اللغة العربية، تقول إن هذه اللغة ترجع في أصولها إلى اللغة الهيروغليفية.كل ذلك يؤكد أن الأمم المجاورة لمصر، خضعت في التاريخ، لحظوظ متشابهة واحدة تجعلها وحدة لا تفصل بينها الأحداث ولا مدّ السياسة وجزرها.
- وظيفة الكعباتكان العرب قبل الإسلام، يحجّون إلى كعباتهم المقدسة مرتين في العام؛ الأولى في الربيع والأخرى في الصيف، لمدة شهرين، وكانت زيارتهم تتقارب مع اقتران الشمس ببرج الثور، وهنا تكمن أهمية الثور عند الفراعنة، حيث يعدّونه رمزًا للذكورة الكونية في الوجود، كما عدّوا كوكب الزهرة رمزًا للأنوثة الكونية.كانت تلك الكعبات إذًا، ملاذًا لعبادات القبائل والحج إليها، ولكلٍّ منها وظيفة تشابه الأخرى، وكانت أيضًا بمثابة مؤسسات علمية للأرصاد الفلكية كما ذكرنا، وهي المكان، أو البقعة التي تدار عبرها منظومة الوجود المرتبطة ليس بضبط التقويم الزمني وبقياس حركة الأفلاك فحسب، بل بحركة الزمن الإلهي أيضًا. وقد حذّر نبي الإسلام من بعض العادات، وإن كان قد أخذ بالكثير مما كان سائدًا، فتقويم النسئ حذّر الرسول منه، لاختلافه عمّا أتى به وتبناه حين شرّع التقويم الهجري، إذ تبنّى التقويم القمري الذي لا يزال المسلمون ياخذون به.
- أهل مكةإذا عدنا قليلًا إلى مرحلة ما قبل طرح المشروع التوحيدي المحمدي، كانت تحكم الجزيرة العربية مجموعات من القبائل، وكانت مكة بطبيعتها ومناخها القاسيين في منخفض بين جبلين، وقليلة المياه وهي عبارة عن وادٍ لا ينفع للزراعة، تحيطها الجبال الجرداء، ومياهها نادرة باستثناء بئر زمزم التي كانت مياهه أقرب إلى المياه المعدنية، وعلى الرغم من سكن أقوام مختلفين مكة، إلا أن السيطرة الأساسية في القرن السادس أصبحت لقريش، حتى أصبح اسم قريش مرادفًا لاسم المدينة مكة. هذا وكانت طبقة الأغنياء والتجّار تسكن في وسطها وبجوار الحرم المكي، في حين كان فقراء مكة ومعظمهم من قريش، يسكنون في الأطراف، وقد جاء قصي بن كلاب فوحّد المدينة تحت قيادة قريش، وفرض سلطته عليها، ففي عهد آل كلاب ومن تلاهم من حكّام، أصبحت قريش تسيطر على مكة التي تحولت إلى محطة ترانزيت (حسب التعبير الشائع اليوم) للقوافل التي تمرّ على أراضيها، وكانت تفرض على كل قافلة مبلغًا من المال، ضريبة مرور. وبهذا الإجراء أصبح أبناء مكة يحمون القوافل ويحرسونها خوفًا من قطاع الطرق، أيضًا أصبحت مكة مركزًا جاذبًا للأقوام المحيطة من أفريقيا، الحبشة وغيرها من جماعات كانت تأتي لكسب رزقها. وكانت أيضًا سوقًا لتجارة العبيد والأرقاء والمواشي وغير ذلك...برزت في مكة طبقة من الأغنياء التجّار، كانت على غاية من الثراء، منهم وأهمهم بعض الخلفاء ممن التحقوا بالرسول كابن سفيان والوليد بن المغيرة وأبي بكر الصديق (بن قحافه) وعثمان بن عفان الذي وجدت في خزانته، حين موته 150 ألف دينار، وخلف خيلًا وإبلًا لا تحصى... والزبير بن العوام بن خويلد الذي بلغت ثروته 50 مليون دينار وألف فرس وألف عبد، إضافة لأراضٍ وعقارات في مصر والكوفة والبصرة. أما عبد الرحمن بن عوف فكانت على مربطه مائة فرس وألف بعير وعشرة آلاف شاة، وسعد بن أبي وقاص التي بلغت أمواله مليونين وستمائة وثمانية وثمانون ألف دينار...ومن النساء خديجة بنت خويلد التي أصبحت في ما بعد زوجة النبي، وأم أبي لهب، وزوجة أبي سفيان والدة معاويه.
- الآب والابن والروح القدس في كتابه العقائد الوثنية في الديانة المسيحية يذكر محمد طاهر التنير أن الأديان التي اعتنقها الإنسان لا تحصى، وأكثرها مشابه لبعضه، والاختلاف محصور باختلاف أسماء الآلهة، لكن المفارفه أنه عندما يأتي نبي يتبعه قومه. وبعدما يتوفى يقوم أتباعه بإدخال بعض العقائد الوثنية التي توارثوها عن جدودهم... كما كانوا يقتبسون من الديانات الوثنية التعاليم التي يحشرونها إلى دينهم، كما جرى مع موسى حينما عبد قومه العجل (بتصرف ص5). ومن المعلوم أن الأمم الوثنية كانت تعبد آلهة متعددة، حتى أنها لم تترك قوة من قوى الطبيعة إلا عبدتها، كإله الرعد وإله الماء وإله الهواء وإله النار وإله الكواكب... ومن الأمم من عبد الحيوان كبني إسرائيل، ومنها من قدّس النبي آدم فقالت إنه َمثلث الأقانيم ودعوه الآب والابن والروح القدس، كالإبراهميين والبابليين والأشوريين... فالإبراهيمون رأوا أن الثالوث المقدس غير منقسم في الجوهر، فـ"برهمة" الآب هو الممثل لمبادئ التكوين والخلق، و"فشنو" الابن يمثل مبادئ الحماية والحفظ، و"سيفا" الروح القدس المبيد والمعيد... أما كريشنا الرب فهو المخلص والروح العظيمة الحافظة للعالم، وهو أيضا أحد الأقانيم الثلاثة، وهو "الإله الواحد". يقول كرشنا: أنا رب المخلوقات جميعها. أنا سرّ الألف والواو والميم (اوم). أنا برهمة وفشنو وسيفا التي هي (ثلاثة آلهة بإله واحد). ويقولون عن هذه الأقانيم الثلاثة: الخالق والحافظ والمهلك.أما الصينيون واليابانيون فلهم تقاليدهم المتشابهة، فهم يعبدون إلهًا مثلث الأقانيم يسمونه "فو" الثالوث النقي أو العقل الأبدي، وهو ذو ثلاثة أشكال وذو صفة واحدة. و"بوذا" هو خلاصة هذه التعاليم ويسمونه "فو". ومن هذا الواحد انبثق ثان، ومن الثاني انبثق الثالث، ومن الثلاثة انبثق كل شيء. وقد اتفقوا على أن أصل كل شيء واحد.أما المصريون القدماء فاعتقدوا بالعقائد نفسها، وقد يكونون هم مبتكروها أو من أضافوا إليها، فقد عبدوا إلهًا مثلث الأقانيم، وقد صوروه على شكل جناح الطير ووكر أفعى، ما يعني اختلاف وظائفه وصفاته. وفي معبد ممفيس تبدو الصورة الواضحة المتشابهة مع معبودات الهنود والصينيين، لكن ملك مصر الفرعوني سأل الكاهن تنيوشوكي أن يخبره هل كان قبله أحد أعظم منه، أو هل يكون بعده من هو أعظم منه؟ فأجاب الكاهن: نعم يوجد من هو أعظم وهو أولا "الله"، ثم "الكلمة"، ومعهما "روح القدس"، وهؤلاء الثلاثة ذو طبيعة واحدة، وهم واحد في ذاته، وعنهم صدرت القوة الأبدية. فاذهب أيها الفاني صاحب الحياة القصيرة.هكذا كانت وظيفة الآلهة، وهكذا نشأت الأديان، فما هي اليوم وظيفة المؤسسات الدينية المتشابهة مع بعضها اليوم؟ وهل تطورت التعاليم الدينية عمّا كانت عليه من قبل؟**** رئيس تحرير مجلة الحداثة وأمين عام حلقة الحوار الثقافي
مكتبة البحث- أحمد بدوي، في موكب الشمس (1 و2)، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة 1950- أحمد يوسف داود، الميراث العظيم، دار المستقبل، دمشق 1991- أرثر هيرمان، فكرة الاضمحلال في التاريخ الغربي، ترجمة طلعت الشايب، المجلس الأعلى للثقافة، القاهره 2000- إلياس المر، الإسلام بدعة نصرانية، لا مكان، لا تاريخ.- أنيس فريحة، ملاحم وأساطير من أوغاريت، دار النهار، بيروت 1980- ب. كوملان، الأساطير الإغريقية والرومانية، ترجمة أحمد رضا محمد رضا، مراجعة محمود خليل النحاس، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1992- خليل أحمد خليل، مضمون الأسطورة في الفكر العربي، دار الطليعة، بيروت 1973- خليل عبد الكريم، النص المؤسس ومجتمعه، دار مصر المحروسة، ط 2، القاهره 2002- خودا بخش، الحضارة الإسلامية، ترجمة علي حسني الخربوطلي، دار الكتب الحديثة، القاهرة 1960- رضا جواد الهاشمي، نظام العائلة في العهد البابلي القديم، جامعة البصرة، بغداد، لا تاريخ- زكريا كايا، حقيقة تاريخ المشرق، منشورات الجبهة المشرقية، بيروت 1994- السيد الأسود، الدين والتصور الشعبي للكون، المجلس العلى للثقافة، القاهرة 2005- شريف حامد سالم، نقد العهد القديم، مكتبة مدبولي، القاهرة 2011- صالح سالم هيكل، مفتاح كتاب الحياة، راجع مقدمة الكتاب لمحمد حسين هيكل، ص 31 وما بعد، مطبعة فؤاد 1930- طريف الخالدي، دراسات في تاريخ الفكر العربي الإسلامي، ط2، در الطليعة، بيروت 1979- عبد الرحمن الشرقاوي، محمد رسول الحرية، عالم الكتب، القاهرة 1962- عيسى الحلو، عصور ما قبل التاريخ وتاريخ بابل القديم، دار الطليعة، بيروت 1960- غريغوريوس الملطي، تاريخ مختصر الدول، سلسلة منابع الثقافة الإسلامية، لا مكان، لا تاريخ.- فاطمه المرنيسي، السلطانات المنسيات، ترجمة جميل معلي وعبد الهادي عباس، دار الحصاد للنشر دمشق 1994- فرحان صالح، المادية التاريخية والوعي القومي عند العرب، ط2، دار الحداثة، بيروت 1981، ومجلة الحداثة، الأعداد من 201 إلى 206، بيروت 2020 – 2021- فريدريك معتوق، مرتكزات السيطرة الشرقية، دار الحداثة، بيروت 2008- فيليب حتي، تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين، دار الثقافة، بيروت 1958، وتاريخ العرب (مطول)، لحتي وإدورد جرجي وجبرائيل جبور، جزء1، دار الكشاف، بيروت 1965- كارل بروكلَمان، تاريخ الشعوب الإسلامية، دار العلم الملايين، ط5، بيروت 1968- لويس جزنبرج، قصص اليهود (ص 93 وما بعدها)، ترجمة جمال الرفاعي، تقديم محمد خليفة حسن، ط2، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة 2002- محمود كامل المحامي، الدولة العربية الكبرى، دار المعارف، مصر 1966- ناجيه الوريمي، زعامة المرأة في الإسلام المبكر، ص 27 وما بعد، دار الجنوب 2016- نبيل محمد رشوان، كفار قريش، منشورات البندقية، القاهرة 2017. ودولة الخلافة العبرانية، منشورات البندقيه، القاهرة 2017- هيرودوت يتحدث عن مصر، ترجمة د. محمد صقر خفاجة، تقديم د. أحمد بدوي، دار القلم، القاهرة 1966
الحداثة (Al Hadatha) – س. 28 – ع. 221 – 222 - شتاء 2022 WinterISSN: 2790 -1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on March 14, 2022 08:20
March 12, 2022
أسرار المصريين القدماء - مقاربة تاريخية في المعتقد الفرعوني

♦ عماد جميل غملوش *
- ملخص عن البحث
تثبت الدراسات التاريخية وأعمال الآثار المتواصلة في مصر، أن فراعنة مصر غير عاديين، ولديهم أسرار لم تزل غر مكتشفة حتى يومنا هذا؛ فتراثهم الضخم مليء بالعجائب والكنوز والأسرار، ويصعب للمرء أن يتخيّل التاريخ من دونهم: من خوفو وهرمه، إلى عجائب امنحوتب وجمال كليوباترا وقوتها. وإذ لا يمكن القول إن أقدم حضارة في التاريخ هي حضارتهم، إلا أننا إذا بحثنا عن الكنعانيين والسومريين وجدنا المصريين بينهم، فقد ولدت تلك الحضارة من البحر المتوسط إلى افريقيا، ومن النيل إلى الصحراء، تاركةً آثارًا شامخة وكبرى مثل: الأهرام والمعابد والمقابر الملكية.يعالج هذا البحث إذًا، جوانب من الاكتشافات الجديدة للحضارة الفرعونية، وبعض أسرارها التي لم تكن معروفة منذ فترة طويلة، منها تفاصيل عن المجتمع المصري آنذاك، ولاسيما واقع الأسرة والزواج والأولاد. وقد ركز البحث على زواج الفرعون ورعايته الأسرة، ولاحظ أن خليفة فرعون قد لا يكون من سلالة الدم نفسها، أو من أقربائه. كذلك أشار البحث إلى أن الفراعنة وإن عاشوا ملوكًا، فهم كانوا عاديين في الحياة الزوجية، وإن سجلوا تفوقًا من ناحية "الألوهية" والاعتقاد والتعامل مع البشر بفوقية، إلا أنه لا تُخفى قدرتهم على اكتساب خشوع الناس ومحبتهم لمئات السنين، ولعل أبرز برهان على ذلك إيمان الناس آنذاك بهم، وعملهم على بناء الأهرامات....الكلمات – المفاتيح: التاريخ القديم، الفراعنة، مصر*

"هبة النيل" هو الوصف الذي أطلقه أبو التاريخ "هيرودوت" (Herodotus) على حضارة مصر الفرعونية القديمة، وذلك بعد زيارة قام بها إلى مصر. وقد صدق الوصف بحيث لا يمكن تخيل وجود حضارة في مثل هذه الصحراء القاحلة لولا مرور نهر النيل فيها، المصدر الأساسي لحياة هذه الحضارة، بما يحمله من طمي وماء وخيرات. والنيل سبب وجودهم، ولكن هم أيضًا أحسنوا الاستفادة من النيل.امتدت حضارة مصر الفرعونية من بلاد النوبة جنوبًا إلى المتوسط شمالًا، ومن سيناء والبحر الأحمر شرقًا وصولًا إلى الصحراء الليبية غربًا، هذا الامتداد لم يكن بالأمر السهل على الإطلاق، على الرغم من أن هذا الإطار الجغرافي المحدد ليس ثابتًا فقد توسعت الحدود المصرية لأكثر من ذلك بكثير. وكما اتسعت الحضارة المصرية مكانيًّا، كذلك امتدت زمانيًّا فمن حيث الاستمرارية والتواصل نحن أمام حضارة امتدت لآلاف السنين، إذ بحسب الآثار الكتابية هي برزت نحو 3200 ق.م. وصولًا إلى العهد الروماني الذي استمر بعد الميلاد. هذه الحضارة التي نحن بصدد دراسة بعض مسائلها، تعرضت لعدة غزوات كبرى وصغرى، وقيل فيها الكثير حتى أن اكتشاف أسرارها لم يكن منذ فترة طويلة على الرغم مما تركته من آثار شامخة وكبرى مثل: الأهرام والمعابد والمقابر الملكية.إن الحضارة المصرية الفرعونية تعدّ من أغنى الحضارات على مستوى التاريخ، إن من حيث التطور (نسبيًّا) الذي وصلت إليه على مستوى العلوم (هندسة، طب، فلك، فيزياء، رياضيات، ملاحة و كيمياء) أو على مستوى الزراعة والصناعة والتجارة بشقيها الداخلي والخارجي. هذه الحضارة التي واجهت الكثير من الأعداء والمصاعب، استطاعت التغلب على أغلبها ابتداءً بالهكسوس وصولًا إلى الآشوريين والفرس والإسكندر المقدوني، وإنتهاءً بالرومانيين.في هذه الحضارة يجد المرء أمة اعتقدت أن مؤسسها الأول مينا (متخذ لقب حورس= الصقر) هو الذي وحدها، بعد أن كانت مملكتين منفصلتين شمالية الدلتا (السفلى) وجنوبية الصعيد (العليا)، وكان لهذا التوحيد الدور الأبرز في إنطلاق هذه الحضارة نحو العالمية، إنها نقطة التحول التي غيّرت مصير مصر من مجرد أقاليم متفرقة لا تكاد تتفق على شيء، إلى أمة فرعونية جمعها النيل ووهبها الحياة.وفيما بلغ اهتمام المصريين القدامى أقصى حده في كل المجالات، لم يغفلوا عن الدين والعقيدة بل أعطوها وافر اهتمامهم، إذ أدى الدين دورًا أساسيًّا في إضفاء القدسية على النظم السياسية الحاكمة في مصر.ولكن يبقى السؤال مطروحًا: ما هو سرّ الفراعنة، فهل هم ملوك آلهة ورسل لها، أم هم أشخاص عاديون استطاعوا من خلال ذكائهم غير العادي ادعاء الألوهية والسير بها؟ومن الناحية الاجتماعية: كيف قُسّم المجتمع المصري القديم إلى الطبقات؟ وما منشأ ذلك؟ وما النتائج التي أدى إليها هذا التقسيم؟ هل اهتم المصريون القدامى بالتربية والتعليم؟ وما هو دور المرأة في المجتمع المصري؟ (...)**** باحث لبناني في التاريخ القديم - رئيس قسم التاريخ في كلية الآداب والعلوم الإنسانية (الفرع الخامس)، ودكتور في كلية التربية - الجامعة اللبنانيةالمصادر والمراجع- إبراهيم، بكر محمد. (2007). غرائب وعجائب الفراعنة. القاهرة: مركز الراية للنشر والإعلام- أمهز، محمود. (2011). في تاريخ الشرق الأدنى القديم، ط. 2. بيروت: دار النهضة العربية- باقر، طه. (2011). مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة (حضارة وادي النيل). بغداد: شركة دار الوراق للنشر- بدوي، أحمد والمختار، جمال. (1974). تاربخ التربية والتعليم في مصر العصر الفرعوني. القاهرة: الهيئة العامة المصرية للكتاب- بهران، محمد بيومي. (1999). الثورة الاجتماعية الأولى في مصر الفراعنة. الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية- حواس، زاهي. (2017). الأسرة أيام الفراعنة. الجيزة: دار نهضة مصر للنشر- ديماس، فرنسوا. (1998). آلهة مصر. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب- ديورانت، ويل. (2008). قصة الحضارة. (محمد بدران، المترجم). بيروت: دار نوبيليس- عبد الساتر، لبيب (1986). الحضارات. بيروت: دار المشرق- علي، رمضان عبده. (1999). حضارة مصر القديمة. القاهرة: المجلس الأعلى للآثار- العيسوي، محمود. (1991). الأسرة في المجتمع المصري القديم. الإسكندرية: دار القلم- عيسى، هيام. (2018). تاريخ مصر الفرعونية وحضارتها. صيدا: مكتبة النبيل (كراس جامعي)- النشار، مصطفى. (1998). الخطاب السياسي في مصر القديمة. القاهرة: دار أنباء للطباعة والنشر- يونيم، ماري أنج. (2007). الفرعون وأسرار السلطة، ط.1. (فاطمة محمود، مترجمة). القاهرة: المركز القومي للترجمة
- الأجنبية:
- Dr. Binod Bihari Satpathy. (بلا تاريخ). Ancient civilization- James Taylor. (1979) an introduction to ancient eygpt. London: British museum publication- Quirke, s. (2015). Exploring religion in ancient egypt. oxford: Wiley Blackwell
الحداثة (Al Hadatha) – س. 28 – ع. 221 – 222 - شتاء 2022 WinterISSN: 2790 -1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on March 12, 2022 04:45
أسرار اÙ٠صرÙÙ٠اÙÙد٠اء - Ù Ùاربة تارÙØ®ÙØ© Ù٠اÙ٠عتÙد اÙÙرعÙÙÙ

⦠ع٠اد ج٠Ù٠غ٠ÙÙØ´ *
- Ù Ùخص ع٠اÙبØØ«
تثبت اÙدراسات اÙتارÙØ®ÙØ© Ùأع٠ا٠اÙآثار اÙ٠تÙاصÙØ© ÙÙ Ù ØµØ±Ø Ø£Ù ÙراعÙØ© ٠صر غÙر عادÙÙÙØ ÙÙدÙÙ٠أسرار Ù٠تز٠غر Ù ÙتشÙØ© Øت٠ÙÙÙ Ùا ÙØ°Ø§Ø ÙتراثÙ٠اÙضخ٠٠ÙÙØ¡ باÙعجائب ÙاÙÙÙÙز ÙاÙØ£Ø³Ø±Ø§Ø±Ø ÙÙصعب ÙÙ٠رء Ø£Ù ÙتخÙÙ٠اÙتارÙØ® ٠٠دÙÙÙÙ : Ù Ù Ø®ÙÙÙ ÙÙر٠ÙØ Ø¥Ù٠عجائب ا٠ÙØÙتب Ùج٠ا٠ÙÙÙÙباترا ÙÙÙتÙا. Ùإذ Ùا ÙÙ Ù٠اÙÙÙ٠إ٠أÙد٠Øضارة Ù٠اÙتارÙØ® ÙÙ ØضارتÙÙ Ø Ø¥Ùا Ø£ÙÙا إذا بØØ«Ùا ع٠اÙÙÙعاÙÙÙÙ ÙاÙسÙ٠رÙÙÙ ÙجدÙا اÙ٠صرÙÙ٠بÙÙÙÙ Ø ÙÙد ÙÙدت تÙ٠اÙØضارة ٠٠اÙبØر اÙ٠تÙسط Ø¥Ù٠اÙرÙÙÙØ§Ø Ù٠٠اÙÙÙ٠إÙ٠اÙصØØ±Ø§Ø¡Ø ØªØ§Ø±Ùة٠آثارÙا شا٠خة ÙÙبر٠٠ثÙ: اÙØ£Ùرا٠ÙاÙ٠عابد ÙاÙÙ Ùابر اÙÙ ÙÙÙØ©.ÙعاÙج Ùذا اÙبØØ« إذÙØ§Ø Ø¬ÙاÙب ٠٠اÙاÙتشاÙات اÙجدÙدة ÙÙØضارة اÙÙرعÙÙÙØ©Ø Ùبعض أسرارÙا اÙت٠Ù٠تÙ٠٠عرÙÙØ© Ù ÙØ° Ùترة Ø·ÙÙÙØ©Ø Ù ÙÙا تÙاصÙ٠ع٠اÙ٠جت٠ع اÙ٠صر٠آÙذاÙØ ÙÙاسÙ٠ا ÙاÙع اÙأسرة ÙاÙزÙاج ÙاÙØ£ÙÙاد. ÙÙد رÙز اÙبØØ« عÙ٠زÙاج اÙÙرعÙÙ ÙرعاÙت٠اÙØ£Ø³Ø±Ø©Ø ÙÙاØظ Ø£Ù Ø®ÙÙÙØ© ÙرعÙÙ Ùد Ùا ÙÙÙ٠٠٠سÙاÙØ© اÙد٠ÙÙسÙØ§Ø Ø£Ù Ù Ù Ø£ÙربائÙ. ÙØ°Ù٠أشار اÙبØØ« Ø¥Ù٠أ٠اÙÙراعÙØ© Ùإ٠عاشÙا Ù ÙÙÙÙØ§Ø ÙÙÙ ÙاÙÙا عادÙÙÙ Ù٠اÙØÙاة اÙزÙجÙØ©Ø Ùإ٠سجÙÙا تÙÙÙÙا Ù Ù ÙاØÙØ© "اÙØ£ÙÙÙÙØ©" ÙاÙاعتÙاد ÙاÙتعا٠٠٠ع اÙبشر بÙÙÙÙØ©Ø Ø¥Ùا Ø£ÙÙ Ùا تÙØ®ÙÙ ÙدرتÙ٠عÙ٠اÙتساب خشÙع اÙÙاس ÙÙ ØبتÙÙ Ù٠ئات اÙسÙÙÙØ ÙÙع٠أبرز برÙا٠عÙÙ Ø°Ù٠إÙ٠ا٠اÙÙاس Ø¢Ùذا٠بÙÙ Ø Ùع٠ÙÙ٠عÙ٠بÙاء اÙØ£Ùرا٠ات....اÙÙÙ٠ات â اÙÙ ÙاتÙØ: اÙتارÙØ® اÙÙدÙÙ Ø Ø§ÙÙراعÙØ©Ø Ù ØµØ±*

"Ùبة اÙÙÙÙ" Ù٠اÙÙص٠اÙذ٠أطÙÙ٠أب٠اÙتارÙØ® "ÙÙرÙدÙت" (Herodotus) عÙÙ Øضارة ٠صر اÙÙرعÙÙÙØ© اÙÙدÙÙ Ø©Ø ÙØ°Ù٠بعد زÙارة Ùا٠بÙا Ø¥Ù٠٠صر. ÙÙد صد٠اÙÙص٠بØÙØ« Ùا ÙÙ Ù٠تخÙÙ ÙجÙد Øضارة ÙÙ Ù Ø«Ù Ùذ٠اÙصØراء اÙÙاØÙØ© ÙÙÙا ٠رÙر ÙÙر اÙÙÙÙ ÙÙÙØ§Ø Ø§Ù٠صدر اÙأساس٠ÙØÙاة Ùذ٠اÙØØ¶Ø§Ø±Ø©Ø Ø¨Ù Ø§ ÙØÙ ÙÙ Ù Ù Ø·Ù Ù Ù٠اء ÙØ®Ùرات. ÙاÙÙÙ٠سبب ÙجÙدÙÙ Ø ÙÙÙÙ Ù٠أÙضÙا Ø£ØسÙÙا اÙاستÙادة ٠٠اÙÙÙÙ.ا٠تدت Øضارة ٠صر اÙÙرعÙÙÙØ© ٠٠بÙاد اÙÙÙبة جÙÙبÙا Ø¥Ù٠اÙ٠تÙسط ش٠اÙÙØ§Ø Ù٠٠سÙÙاء ÙاÙبØر اÙØ£Ø٠ر شرÙÙا ÙصÙÙÙا Ø¥Ù٠اÙصØراء اÙÙÙبÙØ© غربÙØ§Ø Ùذا اÙا٠تداد ÙÙ ÙÙ٠باÙأ٠ر اÙسÙ٠عÙ٠اÙإطÙاÙØ Ø¹Ù٠اÙرغ٠٠٠أ٠Ùذا اÙإطار اÙجغراÙ٠اÙÙ Øدد ÙÙس ثابتÙا ÙÙد تÙسعت اÙØدÙد اÙ٠صرÙØ© ÙØ£Ùثر Ù Ù Ø°Ù٠بÙØ«Ùر. ÙÙ٠ا اتسعت اÙØضارة اÙ٠صرÙØ© Ù ÙاÙÙÙÙØ§Ø ÙØ°Ù٠ا٠تدت ز٠اÙÙÙÙا ÙÙ Ù ØÙØ« اÙاست٠رارÙØ© ÙاÙتÙاص٠ÙØ٠أ٠ا٠Øضارة ا٠تدت ÙØ¢Ùا٠اÙسÙÙÙØ Ø¥Ø° بØسب اÙآثار اÙÙتابÙØ© Ù٠برزت ÙØÙ 3200 Ù.Ù . ÙصÙÙÙا Ø¥Ù٠اÙعÙد اÙرÙ٠اÙ٠اÙذ٠است٠ر بعد اÙÙ ÙÙاد. Ùذ٠اÙØضارة اÙت٠ÙØ٠بصدد دراسة بعض ٠سائÙÙØ§Ø ØªØ¹Ø±Ø¶Øª Ùعدة غزÙات Ùبر٠ÙصغرÙØ ÙÙÙÙ ÙÙÙا اÙÙØ«Ùر Øت٠أ٠اÙتشا٠أسرارÙا ÙÙ ÙÙÙ Ù ÙØ° Ùترة Ø·ÙÙÙØ© عÙ٠اÙرغ٠٠٠ا ترÙت٠٠٠آثار شا٠خة ÙÙبر٠٠ثÙ: اÙØ£Ùرا٠ÙاÙ٠عابد ÙاÙÙ Ùابر اÙÙ ÙÙÙØ©.إ٠اÙØضارة اÙ٠صرÙØ© اÙÙرعÙÙÙØ© تعد٠٠٠أغÙ٠اÙØضارات عÙ٠٠ستÙ٠اÙتارÙØ®Ø Ø¥Ù Ù Ù ØÙØ« اÙتطÙر (ÙسبÙÙÙا) اÙØ°Ù ÙصÙت Ø¥ÙÙ٠عÙ٠٠ستÙ٠اÙعÙÙÙ (ÙÙØ¯Ø³Ø©Ø Ø·Ø¨Ø ÙÙÙØ ÙÙزÙØ§Ø¡Ø Ø±ÙاضÙØ§ØªØ Ù ÙاØØ© Ù ÙÙÙ Ùاء) أ٠عÙ٠٠ستÙ٠اÙزراعة ÙاÙصÙاعة ÙاÙتجارة بشÙÙÙا اÙداخÙÙ ÙاÙخارجÙ. Ùذ٠اÙØضارة اÙت٠ÙاجÙت اÙÙØ«Ùر ٠٠اÙأعداء ÙاÙÙ ØµØ§Ø¹Ø¨Ø Ø§Ø³ØªØ·Ø§Ø¹Øª اÙتغÙب عÙ٠أغÙبÙا ابتداء٠باÙÙÙسÙس ÙصÙÙÙا Ø¥Ù٠اÙآشÙرÙÙÙ ÙاÙÙرس ÙاÙإسÙÙدر اÙÙ ÙدÙÙÙØ ÙØ¥ÙتÙاء٠باÙرÙ٠اÙÙÙÙ.ÙÙ Ùذ٠اÙØضارة Ùجد اÙ٠رء Ø£Ù Ø© اعتÙدت أ٠٠ؤسسÙا اÙØ£ÙÙ Ù ÙÙا (٠تخذ ÙÙب ØÙرس= اÙصÙر) Ù٠اÙØ°Ù ÙØدÙØ§Ø Ø¨Ø¹Ø¯ Ø£Ù ÙاÙت Ù Ù ÙÙتÙÙ Ù ÙÙصÙتÙ٠ش٠اÙÙØ© اÙدÙتا (اÙسÙÙÙ) ÙجÙÙبÙØ© اÙصعÙد (اÙعÙÙا)Ø ÙÙا٠ÙÙذا اÙتÙØÙد اÙدÙر اÙأبرز Ù٠إÙØ·Ùا٠Ùذ٠اÙØضارة ÙØ٠اÙعاÙÙ ÙØ©Ø Ø¥ÙÙا ÙÙطة اÙتØÙ٠اÙت٠غÙÙرت ٠صÙر ٠صر ٠٠٠جرد Ø£ÙاÙÙ٠٠تÙرÙØ© Ùا تÙاد تتÙ٠عÙÙ Ø´ÙØ¡Ø Ø¥Ù٠أ٠ة ÙرعÙÙÙØ© ج٠عÙا اÙÙÙÙ ÙÙÙبÙا اÙØÙاة.ÙÙÙ٠ا بÙغ اÙت٠ا٠اÙ٠صرÙÙ٠اÙÙدا٠٠أÙص٠Øد٠ÙÙ Ù٠اÙ٠جاÙØ§ØªØ ÙÙ ÙغÙÙÙا ع٠اÙدÙÙ ÙاÙعÙÙدة ب٠أعطÙÙا ÙاÙر اÙت٠ا٠ÙÙ Ø Ø¥Ø° أد٠اÙدÙ٠دÙرÙا أساسÙÙÙا Ù٠إضÙاء اÙÙدسÙØ© عÙ٠اÙÙظ٠اÙسÙاسÙØ© اÙØاÙÙ Ø© Ù٠٠صر.ÙÙÙÙ ÙبÙ٠اÙسؤا٠٠طرÙØÙا: ٠ا Ù٠سر٠اÙÙراعÙØ©Ø ÙÙÙ ÙÙ Ù ÙÙ٠آÙÙØ© Ùرس٠ÙÙØ§Ø Ø£Ù Ù٠أشخاص عادÙÙ٠استطاعÙا Ù Ù Ø®Ùا٠ذÙائÙ٠غÙر اÙعاد٠ادعاء اÙØ£ÙÙÙÙØ© ÙاÙسÙر بÙاØÙ٠٠اÙÙاØÙØ© اÙاجت٠اعÙØ©: ÙÙÙ ÙÙسÙ٠اÙ٠جت٠ع اÙ٠صر٠اÙÙدÙ٠إÙ٠اÙطبÙØ§ØªØ Ù٠ا Ù Ùشأ Ø°ÙÙØ Ù٠ا اÙÙتائج اÙت٠أد٠إÙÙÙا Ùذا اÙتÙسÙÙ Ø Ù٠اÙت٠اÙ٠صرÙÙ٠اÙÙدا٠٠باÙتربÙØ© ÙاÙتعÙÙÙ Ø Ù٠ا Ù٠دÙر اÙ٠رأة Ù٠اÙ٠جت٠ع اÙ٠صرÙØ (...)**** باØØ« ÙبÙاÙÙ Ù٠اÙتارÙØ® اÙÙدÙÙ - رئÙس Ùس٠اÙتارÙØ® ÙÙ ÙÙÙØ© اÙآداب ÙاÙعÙÙ٠اÙØ¥ÙساÙÙØ© (اÙÙرع اÙخا٠س)Ø ÙدÙتÙر ÙÙ ÙÙÙØ© اÙتربÙØ© - اÙجا٠عة اÙÙبÙاÙÙةاÙ٠صادر ÙاÙ٠راجع- إبراÙÙÙ Ø Ø¨Ùر Ù Ø٠د. (2007). غرائب Ùعجائب اÙÙراعÙØ©. اÙÙاÙرة: ٠رÙز اÙراÙØ© ÙÙÙشر ÙاÙإعÙا٠- Ø£Ù ÙØ²Ø Ù ØÙ Ùد. (2011). Ù٠تارÙØ® اÙشر٠اÙأدÙ٠اÙÙدÙÙ Ø Ø·. 2. بÙرÙت: دار اÙÙÙضة اÙعربÙØ©- باÙØ±Ø Ø·Ù. (2011). Ù Ùد٠ة Ù٠تارÙØ® اÙØضارات اÙÙدÙÙ Ø© (Øضارة Ùاد٠اÙÙÙÙ). بغداد: شرÙØ© دار اÙÙرا٠ÙÙÙشر- بدÙÙØ Ø£Ø٠د ÙاÙÙ Ø®ØªØ§Ø±Ø Ø¬Ù Ø§Ù. (1974). تاربخ اÙتربÙØ© ÙاÙتعÙÙÙ Ù٠٠صر اÙعصر اÙÙرعÙÙÙ. اÙÙاÙرة: اÙÙÙئة اÙعا٠ة اÙ٠صرÙØ© ÙÙÙتاب- بÙراÙØ Ù Ø٠د بÙÙÙ Ù. (1999). اÙØ«Ùرة اÙاجت٠اعÙØ© اÙØ£ÙÙÙ Ù٠٠صر اÙÙراعÙØ©. اÙإسÙÙدرÙØ©: دار اÙ٠عرÙØ© اÙجا٠عÙØ©- ØÙØ§Ø³Ø Ø²Ø§ÙÙ. (2017). اÙأسرة Ø£Ùا٠اÙÙراعÙØ©. اÙجÙزة: دار ÙÙضة ٠صر ÙÙÙشر- دÙÙ Ø§Ø³Ø ÙرÙسÙا. (1998). Ø¢ÙÙØ© ٠صر. اÙÙاÙرة: اÙÙÙئة اÙ٠صرÙØ© اÙعا٠ة ÙÙÙتاب- دÙÙراÙØªØ ÙÙÙ. (2008). Ùصة اÙØضارة. (Ù Ø٠د بدراÙØ Ø§Ù٠ترج٠). بÙرÙت: دار ÙÙبÙÙÙس- عبد اÙØ³Ø§ØªØ±Ø ÙبÙب (1986). اÙØضارات. بÙرÙت: دار اÙ٠شرÙ- عÙÙØ Ø±Ù Ø¶Ø§Ù Ø¹Ø¨Ø¯Ù. (1999). Øضارة ٠صر اÙÙدÙÙ Ø©. اÙÙاÙرة: اÙ٠جÙس اÙأعÙÙ ÙÙآثار- اÙعÙسÙÙØ Ù ØÙ Ùد. (1991). اÙأسرة Ù٠اÙ٠جت٠ع اÙ٠صر٠اÙÙدÙÙ . اÙإسÙÙدرÙØ©: دار اÙÙÙÙ - عÙسÙØ ÙÙا٠. (2018). تارÙØ® ٠صر اÙÙرعÙÙÙØ© ÙØضارتÙا. صÙدا: Ù Ùتبة اÙÙبÙÙ (Ùراس جا٠عÙ)- اÙÙØ´Ø§Ø±Ø Ù ØµØ·ÙÙ. (1998). اÙخطاب اÙسÙاس٠Ù٠٠صر اÙÙدÙÙ Ø©. اÙÙاÙرة: دار Ø£Ùباء ÙÙطباعة ÙاÙÙشر- ÙÙÙÙÙ Ø Ù Ø§Ø±Ù Ø£Ùج. (2007). اÙÙرعÙÙ Ùأسرار اÙسÙØ·Ø©Ø Ø·.1. (Ùاط٠ة Ù ØÙ ÙØ¯Ø Ù ØªØ±Ø¬Ù Ø©). اÙÙاÙرة: اÙ٠رÙز اÙÙÙÙ Ù ÙÙترج٠ة
- اÙأجÙبÙØ©:
- Dr. Binod Bihari Satpathy. (بÙا تارÙØ®). Ancient civilization- James Taylor. (1979) an introduction to ancient eygpt. London: British museum publication- Quirke, s. (2015). Exploring religion in ancient egypt. oxford: Wiley Blackwell
اÙØداثة (Al Hadatha) â س. 28 â ع. 221 â 222 - شتاء 2022 WinterISSN: 2790 -1785اÙØداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on March 12, 2022 04:45
March 10, 2022
دمج التكنولوجية الحديثة في التعليم (دراسة تطبيقية لجهاز ألف باء تاء على 100 طفل لبناني وعربي)

♦ هدى غالب مكارم *
- نبذة عن البحث
شمل التطور التقني والتكنولوجي مختلف جوانب الحياة، وأصبح في متناول فئات المجتمع كافة، ومن مختلف المراحل العمرية، وفيما لهذا الانتشار من جوانب سلبية؛ له أيضًا العديد من الميزات والفوائد.
يسعى البحث إلى التعرف على مراحل النمو اللغوي للطفل، والآلية التي يكتسب بها لغته الأم، بالإضافة إلى التعرف على التقنيات التدريسية السائدة لتحقيق أهداف تربوية عند الطفل، وذلك لتأكيد أهمية استغلال التكنولوجية الحديثة في تطوير الطفل، والعمل على المحافظة على صحته النفسية واستثارة دافعيته الداخلية، وتوجيه طاقته المجمدة أمام الشاشات والأجهزة للعالم الخارجي، وتحفيز حسّ الفضول لديه لاكتشاف العالم من حوله، والاستفادة من البيئة المحيطة به لاكتساب العديد من المعارف والخبرات؛ كل ذلك يتم بطريقة علمية منهجية مدروسة بواسطة مجموعة من الأطباء والمهندسين والعلماء النفسيين، عن طريق استخدام "جهاز ألف باء تاء" الذي يستهدف مختلف الجوانب المعرفية والسيكولوجية للطفل.- الكلمات المفتاحية: التطور التقني، دمج التكنولوجيا، تعلم لغات جديدة، الديفايس ألف باء تاء
· براءة الاختراع: حاز هذا العمل (جهاز مبرمج كمدرسة من دون مدرس، ويراعي مراحل العمر والمستويات العقلية) براءة اختراع من: الجمهورية اللبنانية - وزراة الاقتصاد والتجارة (المديرية العامة للاقتصاد والتجارة - مصلحة حماية الملكية الفكرية)، تحت رقم: 10904، بتاريخ: 3/5/2016.· شكر وتقدير: أشرف على هذا البحث وتابعه: د. أنطوان موريس الشرتوني** (إشراف)، ود. حمدة عبد الله فرحات*** (عضوة)، وأتوجه إليهما بالشكر والتقدير لجهودهما معي في إكمال البحث على الوجه المطلوب، كذلك قد أشرت إليهما حيث يلزم في طيات البحث. كذلك لا بدّ لي من توجيه الشكر إلى الفنان الراحل سامي كلارك الذي ساعدنا في تسجيل الأغاني المستهدفة في البحث قبل وفاته المفاجئة، والشكر موصول إلى كل الأشخاص الذين ساعدوني في بعض الإجراءات وخطوات التنفيذ والتطبيق.*

يشكل التقدم العلمي أبرز ما يميز الواقع العالمي الذي نعيشه، ولاسيما التطور التكنولوجي الذي أصبح مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا مع جميع متطلبات الحياة ويسير معها بالتوازي، وليس من الخفي أن قوة الأمم تقدّر بما تحرزه من تقدم على المستوى العلمي والتكنولوجي، فقد أصبحت التكنولوجيا الحديثة ملازمة للإنسان بمختلف أشكالها وفي جميع الأوقات.لمواكبة عجلة هذا النمو التقني السريع، كان لا بدّ من إجراء تعديلات على المنظومة التعليمية، إذ أصبح لزامًا على المدرسة والمؤسسات التعليمية الأخرى أن تكيف نظامها التعليمي مع التكنولوجيا السائدة في الوقت الراهن، ذلك لما له من أهمية في تطوير العلم وتسهيل العملية التعليمية، وترك أثر إيجابي على المتعلم الذي يعدّ المحور والأساس في هذه العملية، لذلك وجب دمج تكنولوجيا التعليم في البرامج التعليمية الحديثة لضمان جودة مخرجات التعليم ونجاحها.وقد قدمت التكنولوجيا الحديثة وسائل وأدوات أدت دورًا كبيرًا في تطوير عملية التعليم والتعلم، وأتاحت الفرصة لتحسين أساليب التعلم، وساعدت على إثارة دافعية الطلبة وتشجيعهم، حيث إن توظيفها في العملية التعليمية يسهم في تسهيل عملية التعلم وبعض العمليات الإدارية. لذا توجب على الاختصاصيين إطلاق العنان لتفكيرهم المبدع لبناء سياسة تعليمية قائمة على التكنولوجيا الحديثة (نصر. 2015: 2).ونظرًا إلى الانفجار المعرفي وتدفق المعلومات، أصبح من الضرورة الملحة الاهتمام باستخدام الابتكارات الجديدة في التعليم، وهو ما يسعى هذا البحث إلى توضيحه.
- مشكلة البحث
شهد التعليم تطورًا وتغيرًا في أساليبه مع مرور الزمن، حيث انتقل من الأساليب البدائية التي تقوم على ما يقصّه الآباء لأولادهم، والمحاكاة التي يقوم بها الأبناء لسلوكيات الكبار، إلى ظهور مدارس نظامية خاصة بطبقة معينة من الأشخاص كرجال الدين، كان يتم فيها حفظ التراث وتعليم الرموز، ثم توسع التعليم في ما بعد ليشمل العامة، في مرحلة تالية في العصور الوسطى (المسيحية) تم الاهتمام بالفلسفة وكانت مهمة التعليم توكل إلى رجال الدين، الذين انقسموا إلى نوعين:- معلمو المرحلة الأولى: وهم من يعلمون الأطفال القراءة والكتابة وبعض الألحان الكنسية.- معلمو التعليم العالي: يدرسون الدراسات اللاهوتية في أمور الدين والعقيدة وهي حكر على أبناء الملوك.أما عن التعليم في العصور الإسلامية، فهو يقسم إلى:- معلمي الكتاب: وهم من لديهم معرفة قليلة- معلمي المساجد والمدارس: وهم يتمتعون بدرجة عالية من العلم. (الدويكات. 2017: 2)ثم تطور التعليم في ما بعد إلى أساليب حديثة تتضمن التفاعل مع الطلاب، من خلال:- طرح الأسئلة بدلًا من إعطاء الإجابات بهدف التركيز على موضوع الدراسة بدلًا من التكرار الببغائي للإجابات.- الانتقال من التلقين إلى الاستكشاف، ويكون بإشراك التلميذ في العملية التعليمية من خلال قيامه بعمليات البحث عن المعلومات.وبحسب زيادنه؛ هناك التعليم الإبداعي أيضًا الذي ينمّي القدرات الإبداعية، ويشجع الأفكار المختلفة لدى الطلاب، كما يمكن دمج المواد المسموعة والمرئية لطرح المعلومات. (زيادنه. 2019: 3)سادت هذه الأساليب في المدراس لسنوات عديدة، عمل المدرسون من خلالها على تزويد طلابهم بالمعرفة والمعلومات بنجاح، ومع تطور المجتمع والتكنولوجيا أصبحت هذه الأساليب عاجزة عن تطوير العمليات العقلية والمهارات الأخرى لدى الطلاب، وانطلاقًا مما سبق كانت مشكلة البحث التي ترمي للإجابة عن السؤال الآتي:كيف ينمو الطفل لغويًّا؟ وماهي التقنيات التدريسية المناسبة لتحقيق الهدف من العملية التعليمية باستخدام التكنولوجيا الحديثة؟.وللإجابة عن هذا السؤال لا بدّ أن يسبقه طرح عدة أسئلة والإجابة عنها، وهي:ماهي طرائق تمكين الطفل من لغات مختلفة كلغة أم؟ماهي تقنيات التدريس المناسبة لتحقيق الأهداف التعليمية؟ماهي أساليب تقوية العمليات الذهنية للحفاظ على الصحة النفسية للطفل؟ماهي استراتيجيات الحفاظ على الدافعية لدى المتعلم أثناء عملية التعلم؟ماهي طرق تقديم المحتوى التعليمي للمتعلم بشكل متقدم بعيدًا من مخاطر التكنولوجيا؟
 - أهمية البحث:
- أهمية البحث:تنبع أهمية البحث في كونه:- يمثل إحدى القضايا المهمة في مجتمعنا التي تحتاج إلى بحث جاد ومتعمق يقدم الإجابات عن أسئلة متعددة يمكن أن تطرح في هذا المجال.سئلة أ- يسلط الضوء على دراسة الفروق في التعليم قبل إدخال التكنولوجيا الحديثة وبعدها (الجهاز التعليمي) في عملية التعليم، بالإضافة إلى أن أساليب التدريس القائمة على الحوار والنقاش والمحاكاة في الجهاز، تحقق الأهداف التعليمية عبر الطرائق المناسبة، وعمله على تقوية العمليات الذهنية وتنمية الدافعية الداخلية للمتعلم.يضاف إلى ذلك، إن الفئة المستهدفة في هذا البحث جديرة بالاهتمام وإجراء الأبحاث المعمقة حولها، كونها تشكل حجر الأساس في تكوين شخصية الأفراد.
- أهداف البحث:

معرفة الفروق في عملية التعلم لدى الأطفال قبل استخدام الجهاز التعليمي وبعده.معرفة الفروق في اكتساب اللغة لدى الأطفال قبل استخدام الجهاز التعليمي وبعده.معرفة الفروق في العمليات الذهنية لدى الأطفال قبل استخدام الجهاز التعليمي وبعده.معرفة الفروق في الصحة النفسية لدى الأطفال قبل استخدام الجهاز التعليمي وبعده.معرفة الفروق في الدافعية الداخلية للأطفال قبل استخدام الجهاز التعليمي وبعده.آمن للأطفال بنسبة 100%، حيث أن ترددات الصوت ونسبته خاضعة لنسبة عالية من الدراسة كي تكون ملائمة ومناسبة لأذن الطفل في كل الأعمار، بالإضافة إلى إمكانية استخدامه خلال المدرسة أو السباحة أو اللعب أو قيامه بأي نشاط آخر. وهو بخلاف الأجهزة الإلكترونية الأخرى كالموبايل والكمبيوتر والتلفاز التي تسبب ضررًا إذا اُستخدمت لفترة طويلة، فهذا الجهاز أُخضع لدراسة معمقة، وهو لا يحتوي على ذبذبة مطلقًا.- الطفل: هو الصغير من كلّ شيء، وقيل الطفل بأنه المولود، وولد كل وحشية، والمولود ما دام ناعمًا رضيعًا، وقد يكون الطفل واحدًا، أو جمعًا.وعرف الطفل أيضًا بأنه كلّ جزء من كلّ شيء عينًا كان أو حدثًا، والطفل يدعى طفلًا منذ أن يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم، والطفل جمعه أطفال، ويستوي في ذلك الذكر والأنثى (الخطيب. 2011: 20).وحسب اتفاقية حقوق الطفل العام (1989) تم تعريف الطفل: "كلّ إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه". (أبو خزيمة. 2010: 49)***
* هدى غالب مكارم: اختصاصية في علم النفس المدرسي، مخترعة فكرة الديفايس، ومن مؤسسي شركة فيثولوجي وهي شركة عالمية انبثقت من ابتكارات عديدة، ملمة بمواضيع تغيير مجرى العالم من خلال التصنيع والإبداع والتثقيف والاختراع، شركة أوجدت لغة جديدة للعالم لفهم وكسب الأمور بطرائق سلسة مرنة بأسلوب جديد متطور يتخطى التطور التكنولوجي.
** د. أنطوان موريس الشرتوني: كاتب في أدب الأطفال على مستوى العالم، مؤسس دار سكولا للنشر والتوزيع، أستاذ مساعد في الجامعة اللبنانية (كلية الصحة العامة وكلية الآداب والعلوم الإنسانية)، اختصاصي ومعالج نفسي، مشرف على مذكرات بحث الجامعة اللبنانية كلية الصحة العامة - ماستر المتابعة النفس جسدية، مشرف على مذكرات بحث الجامعة اللبنانية كلية الآداب والعلوم الإنسانية - قسم علم النفس، كاتب وباحث في ميدان الاختبارات النفسية والإسقاطية، مسؤول عن قسم ورش العمل في مركز "نفسانيون في لبنان"، عضو محكم للجائزة العالمية لأدب الأطفال، عضو في الهيئة العالمية لاختبار رورشاخ والاختبارات الإسقاطية للبلدان الفرنكوفونية، عضو في الهيئة الفرنكوفونية للعلاج بالكتب، عضو مؤسس للهيئة اللبنانية للعلاج النفسي بالموسيقى كتقنية مرافقة، كاتب مقالات في مواضيع نفسية وتربوية- جريدة الجمهورية، مدير مركز المجال للشباب والصبايا ذوي الاحتياجات الخاصة، معد ومقدم برامج تلفزيونية وإذاعية.*** د. حمدة عبد الله فرحات: أستاذة علم النفس العيادي والمرضي في الجامعة اللبنانية، مشرفة ومنسقة لمرحلة الماستر، حائزة على شهادة التربية الموسيقية من كلية التربية الجامعة اللبنانية، درست الموسيقى في الكونسرفاتوار وعملت في عدة فرق مع الأساتذة: سليم فليفل وسليم سعد وفرقة خاصة، شاركت في المهرجانات الوطنية، ومع الفنان العالمي الراحل سامي كلارك. معالجة نفسية، ومعالجة بالموسيقى، ومؤلفة للموسيقى العلاجية والتربوية، رئيسة ومؤسسة "الجمعية اللبنانية للعلاج بالموسيقى" كوسيط أول من أدخل العلاج بالموسيقى إلى لبنان، حائزة شهادة الدكتوراه في علم النفس العيادي والمرضي من جامعة ليون في فرنسا، أستاذة للموسيقى لسنوات عدة، ناقدة في الموسيقى وعلم النفس، لها العديد من المقالات العلمية والمقابلات الإذاعية والتلفزيونية وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي.**** ايفار فرحات: مؤلف موسيقي، عازف بيانو ومؤلف للموسيقى العلاجية، بدأ بتأليف المقطوعات الموسيقية منذ عمر السبع سنواتملاحظة: يشار إلى أن دانيال فرحات قد شارك بقطعة موسيقية للاسترخاء. وراني فرحات قد شارك بقطعتين موسيقيتين إحداهما للنوم وأخرى للتحفيز قبل الدرس.
قائمة المراجع
- أبو خزيمة، عبد العزيز مندوة. (2010). الحماية الدولية للأطفال أثناء النزاعات المسلحة دراسة مقارنة. رسالة ماجستير، جامعة الإسكندرية، الإسكندرية.- ايشو، نوال. (2016). أثر البيئة المحيطة في الاكتساب اللغوي لدى الطفل. رسالة ماجستير غير منشورة، الجزائر: جامعة أبي بكر بلقايد الصفحات 1 ومن 34 -41.- براكو، فاطمة، وناجمي، خديجة. (2015). تعلم اللغات الأجنبية (اللغة الفرنسية والانجليزية) وعلاقتها بالتحصيب الدراسي. رسالة ماجستير، الجامعة الإفريقية أدرار، الجزائر.- بن يوسف، أمال. (2008). العلاقة بين استراتيجيات التعلم والدافعية للتعلم وأثرهما على التحصيل الدراسي. رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، الجزائر.- خرما، نايف، حجاج، علي. (1988). اللغات الأجنبية تعليمها وتعلمها. الكويت: عالم المعرفة.- الخطيب، حسن أنور حسن. (2011). الحماية القانونية للأطفال أثناء النزاعات المسلحة. رسالة ماجستير، جامعة القدس، فلسطين.- دليل المعلم للتقييم. (1999). بيروت: وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة، المركز التربوي للبحوث والإنماء- الدويكات، سناء. (2017، 8 أيار). مراحل تطور مهنة التعليم. تم استرجاعها في تاريخ 11 أيلول 2021 من: http://www.mawdoo3.com- الزراد، فيصل محمد خير. (2009). الأمراض النفسية – الجسدية، ط.2، بيروت: دار النفائس- زيادنه، سرى. (2019، 23 كانون الثاني). تطوير التعليم. تم استرجاعها في تاريخ 11 أيلول، 2021 من: http://www.mawdoo3.com .- ساكس، أوليفر. (2010). نزعة إلى الموسيقى، ترجمة: رفيف كامل غدار، بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون.- الشهري، مريم. (2016، 7 شباط). التعلم بالنمذجة ونظرية التعلم الاجتماعي. تم استرجاعها في تاريخ 20 أيلول، 2021 من: http://www.new-educ.com .- الشوبكي، محمد عبد الكريم. (2012، 18 كانون الأول). الموسيقى تسهم في علاج الأمراض النفسية. جريدة الغد.- عريفج، سامي سلطي. (2007). سيكولوجيا النمو دراسة الطفل ما قبل المدرسة (ط3). عمان: دار الفكر- فاخوري، كفاح، حداد، فريدا. (1979). خبرات موسيقية للعامل الاجتماعي، ط.1، منشورات مركز التدريب الاجتماعي، منظمة الأمم المتحدة للأطفال- القني، عبد الباسط. (2020). دافعية التعلم ودافعية الإنجاز مفهوم وأساسيات. الجزائر: جامعة عمار ثليجي الأغواط.- قوعيش، نصر الدين. (2015). معوقات نشاط التعبير الشفهي في الطور الابتدائي. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، الجزائر.- متيجي، فايزة، وعمارة، سعاد. (د.ت). أثر التطور التكنولوجي على العملية التعليمية عند الطفل. شهادة ليسانس. جامعة أكلي محند أولحاج: الجزائر.- المدني، محمد. (2017). الموسيقى الدينية، ط.2، دمشق: دار كنعان للنشر- مليك، سامية، وحميداني، لزهاري. (2020). الدافعية للتعلم وعلاقتها بالتحصيل الدراسي لدى تلاميذ السنة الرابعة متوسط. رسالة ماجستير، جامعة الشهيد لخضر، الأردن.- منظمة الصحة العالمية. (2005). تعزيز الصحة النفسية المفاهيم. البيانات المستجدة. الممارسة. القاهرة: المكتب الإقليمي لشرق التوسط.- نصر، لبنا. (2015). فاعلية برنامج دمج التكنولوجيا بالتعليم في تنمية بعض مهارات تطبيقات الحاسوب والانترنت لدى المعلمين المتدربين ووجهة نظرهم حوله. رسالة ماجستير، جامعة تشرين، اللاذقية.- Chahine, Nada. (2016). l'effet de l'éducation musicle sur le rendement scolaire, Mémoire en psychologie, sous la direction de Docteur Hamda Farhat, Unversté Libanaise.- Farhat, Hamda. (2009). La musique comme médiation thérapeutique dans le traitement de la dépression, thèse de Doctorat sous la direction de Monsieur le Professeur Yves Morhain, Université Lumière Lyon2.- lecourt, Edit. (1993). Analyse de groupe et musicotherapie, ESF, Paris.- Lecourt, Edit. (2014). La musicotherapie, Eyrolles, Paris.- Médiatios Musicales Médiations Thérapeutiques,(2018), collectif d'auteurs , conférence internationale, sidi bou said, tunis.
الحداثة (Al Hadatha) – س. 28 – ع. 221 – 222 - شتاء 2022 WinterISSN: 2790 -1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on March 10, 2022 14:27
مجلة الحداثة - Al Hadatha Journal
Al Hadatha Journal - A Refereed Academic Quarterly
مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة
تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)
ISSN/2790 Al Hadatha Journal - A Refereed Academic Quarterly
مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة
تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)
ISSN/2790-1785
تُعنى المجلة بنشر الأبحاث الأكاديمية بعد عرضها على لجنة علمية متخصصة. وتبلورت فكرة نشوء المجلة بعد اجتماعات عمل متواصلة بين رئيس تحريرها فرحان صالح وأصدقاء باحثين وأكاديميين من لبنان والعالم العربي، وقد بات عدد منهم ضمن الهيئة الاستشارية للمجلة، علمًا أن بعضهم قد فارق الحياة، وقد جرى إضافة أسماء إلى الهيئة لاحقًا. تغطي مجلة الحداثة الأبحاث التي تأتي من شريحة واسعة من الأكاديميين والمفكرين والكتّاب والأدباء في لبنان والعالم العربي، فتنشر موضوعات تتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والسياسية، كذلك، موضوعات تتعلق بقضايا فكرية وتراثية وأدبية ونقدية وفنية وإعلامية ...more
مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة
تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)
ISSN/2790 Al Hadatha Journal - A Refereed Academic Quarterly
مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة
تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)
ISSN/2790-1785
تُعنى المجلة بنشر الأبحاث الأكاديمية بعد عرضها على لجنة علمية متخصصة. وتبلورت فكرة نشوء المجلة بعد اجتماعات عمل متواصلة بين رئيس تحريرها فرحان صالح وأصدقاء باحثين وأكاديميين من لبنان والعالم العربي، وقد بات عدد منهم ضمن الهيئة الاستشارية للمجلة، علمًا أن بعضهم قد فارق الحياة، وقد جرى إضافة أسماء إلى الهيئة لاحقًا. تغطي مجلة الحداثة الأبحاث التي تأتي من شريحة واسعة من الأكاديميين والمفكرين والكتّاب والأدباء في لبنان والعالم العربي، فتنشر موضوعات تتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والسياسية، كذلك، موضوعات تتعلق بقضايا فكرية وتراثية وأدبية ونقدية وفنية وإعلامية ...more
- مجلة الحداثة's profile
- 11 followers




