مجلة الحداثة's Blog: مجلة الحداثة - Al Hadatha Journal, page 11
September 21, 2022
الافتتاحية: المغرب والمشرق

♦ خالد زيادة *
امتزج المغرب في الذاكرة المشرقية بالتاريخ، بثقافته وأسماء أعلامه وخصوصًا أولئك الذين وفدوا من بلدانه ومدنه ليستقروا في مصر أو سوريا أمثال ابن عربي وابن خلدون أو أولئك الذين عبروا مدن الشرق في أسفارهم الطويلة أمثال ابن جبير وابن بطوطة. كانت بلاد الحجاز محط أنظار المغاربة الذين يبغون الحج ولو لمرة واحدة. هذا الموسم السنوي كان يخلف وراءه العديد من الأفراد الذين استقروا في مدن المشرق مثل القاهرة والقدس وبيروت ودمشق، حيث صار لكل مدينة حيّ للمغاربة، اندمجوا في الحياة المشرقية واحتفظوا في ذاكرتهم حتى يومنا هذا بأصولهم المغربية.والواقع أن افتراق المصير السياسي للمغرب الأقصى عن سائر البلاد العربية قد بدأ مع مطلع القرن السادس عشر، إذ خضعت كل البلدان بما في ذلك الجزائر وتونس للسيطرة العثمانية، إلا أن المغرب بقي بعيدًا من التأثير السياسي و"الثقافي" العثماني. ونشير أيضًا إلى أن المغرب لم يتأثر بعصر التنظيمات الذي ترك آثارًا بارزة في ميادين التعليم والقضاء والتنظيم العسكري بالرغم من أن أثر التنظيمات كان بارزًا في تونس في عهدي الباي أحمد والباي محمد الصادق، وكان خير الدين التونسي أبرز معبر عن روح التنظيمات.لم يتطلع أبناء المشرق إلى المغرب ولم يكن مقصدهم لا للزيارة ولا للتجارة. ولم تصل أخبار المغرب إلى الشرق إلا مع ظهور الصحافة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين مع ثورة الريف وعبد الكريم الخطابي. وكان ينبغي انتظار الخمسينات حتى يحضر المغرب بقوة في المشرق مع الاستقلال وزيارة الملك محمد الخامس إلى القاهرة العام 1960 حيث لقي حفاوة بالغة. حدث ذلك مع صعود حركات التحرر والاستقلال، الذي عُدّ انتصارًا للعروبة والأمل بوحدة للمشرق والمغرب.كان تأثير المشرق كبيرًا على المغرب، في بدايات الحقبة الحديثة، أي في نهاية القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين. وهو تأثير يتعلق بالنخب أكثر مما يتعلق بالعامة. كانت الصحف التي ازدهرت في المشرق وخصوصًا في مصر تصل مقالاتها عن الدستور والحرية والسياسة إلى المغرب الأقصى، وكان للإصلاحية ممثلة بالإمام محمد عبده تأثيرها على الجمعيات الاسلامية، وحضر المشرق ومصر خاصة في الثقافة المغربية من خلال أعمال طه حسين والعقّاد وسواهما.إلا أن التأثير الثقافي الذي تواصل في خمسينيات القرن العشرين، توقف عند حدود التأثير السياسي والايديولوجي. فلم تستطع الأيديولوجيات القومية والاشتراكية التي ازدهرت في المشرق أن تجد أرضًا خصبة في المغرب. خصوصًا أن العروبة انبثقت في نهاية القرن التاسع عشر من خلال التناقض مع "العثمانية"، ثم تميز العروبة عن الإسلام بالعودة إلى التراث ما قبل الإسلامي، فلم تتردد أصداؤها في المغرب، ذلك أن النخب المغربية لم تضع حدودًا فاصلة بين الإسلام والعروبة.وقد أسهم الصراع العربي الإسرائيلي في تشكيل الوعي المشرقي، وجذب التيارات السياسية والفكرية إلى أرضية هذا الصراع، ولا شك أن التطورات السياسية في الأربعينات والخمسينات، وخصوصًا الانقلابات العسكرية، قد أدت إلى هيمنة الخطابات الأيديولوجية على التفكير النقدي والبحث العلمي لدى النخب الثقافية.والريادة المشرقية في مجال الفكر خصوصًا، تراجعت أمام الصراعات الأيديولوجية في ظل الأنظمة الأحادية العسكرية التي تروج للشعارات على حساب التفكير النقدي الحر. وأصبحت السجالات بين التيارات القومية والاشتراكية والدينية الشغل الشاغل لأصحاب الرأي والكتّاب، وبقيت بيروت التي لم تكن بمنأى عن هذه السجالات، مركزًا للنشر تستقطب أعمال الأدباء والمفكرين والباحثين حتى في سنوات الحرب التي عرفها لبنان في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، إلا أن ذلك لم يكن يعكس حيوية فكرية لا في لبنان ولا في سوريا والعراق، ولا في مصر التي دخلت في عزلة ثقافية، فلا تتأثر بما يجري حولها، ولا تؤثر في محيطها العربي.والمظهر الآخر لتراجع التأثير المشرقي في حركة الأفكار هو اضمحلال التأثير الغربي في البلدان التي تحكمها أيديولوجية الحزب الواحد، التي تراقب كل ما يهدد عقيدتها باسم الحفاظ على الخصوصية ورفض "الأفكار المستوردة". لقد مزقت حروب الأيديولوجيات والمذهبيات لبنان والعراق وسوريا، وجعلتها صحراء قاحلة فكريًا.هذا ما يجدر أن نأخذ به حين نقارن بين المشرق والمغرب وخصوصًا لجهة الإنتاج الفكري. تفادى المغرب صراع الأيديولوجيات ونأى بنفسه عن التطورات المشرقية. بل يمكن أن نلاحظ مسارين مختلفين: ففي المشرق وأثر خروج دول الاستعمار ونيل الاستقلال، تراجع تأثير أوروبا الفكري. وأدت الدعوة الإيجابية إلى تعريب التعليم إلى نتائج عكسية فلم يحصل تحديث للعربية ونحوها وقواعدها، ولا حدث تعريب للعلوم كما يُفترض. أما في المغرب، فإن الانتقال إلى مرحلة الاستقلال لم يترافق مع دعوات للتخلّص من إرث الثقافة الغربية، ولعل ما حصل هو العكس فقد اضطردت صلات المغرب مع الثقافة الأوروبية وخصوصًا الفرنسية، على المستوى الجامعي الأكاديمي.ونجد تأثرًا مبالغًا فيه بالمنهجيات الحديثة، وتأثيرًا لمفكرين من أمثال ميشال فوكو وجاك دريدا وغيرهما، وثمة اجتهاد لمواكبة التيارات الفكرية الحديثة. وفي جميع الأحوال فإن الجامعيين من المغرب يحضرون بشكل ملحوظ وكثيف في الدوريات التي ما زالت تصدر في بلدان الشرق، وتنتشر مؤلفاتهم عبر دار النشر التي لا تزال تحتفظ ببعض نشاطها في بيروت خصوصًا.***
* باحث وأكاديمي من لبنان
الحداثة (Al Hadatha) – س. 29 – ع. 224 - صيف 2022 SummerISSN: 2790-1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on September 21, 2022 05:00
البحث عن السيرة المحمدية (مقاربات في التاريخ والأسطورة والمرويات الشعبية)
[image error]
♦ فرحان صالح *
نبذة عن البحث
يقدم هذا البحث مقاربات غير تقليدية لبدايات نشوء الإسلام والسيرة المحمدية، وذلك عبر الاستناد إلى مجموعة من المصادر والمراجع والوثائق التاريخية، فضلًا عن مرويات شعبية يهودية ومسيحية وبيزنطية... متناثرة في طيات الكتب لم يصر إلى الإضاءة عليها بشكلٍ كافٍ، لأسباب مختلفة.وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج والخلاصات قد تساهم بإعادة النظر الموضوعي والواعي في بعض الأحداث التاريخية والدينية بعيدًا من التخيلات التي شابها الكثير من أساليب الأساطير والخرافات.- الكلمات المفاتيح: إسلام، سيرة، آريوسية، مسيحية، مرويات شعبية**** باحث من لبنان، له العديد من المؤلفات والكتابات المنشورة
الحداثة (Al Hadatha) – س. 29 – ع. 224 - صيف 2022 SummerISSN: 2790-1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
♦ فرحان صالح *
نبذة عن البحث
يقدم هذا البحث مقاربات غير تقليدية لبدايات نشوء الإسلام والسيرة المحمدية، وذلك عبر الاستناد إلى مجموعة من المصادر والمراجع والوثائق التاريخية، فضلًا عن مرويات شعبية يهودية ومسيحية وبيزنطية... متناثرة في طيات الكتب لم يصر إلى الإضاءة عليها بشكلٍ كافٍ، لأسباب مختلفة.وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج والخلاصات قد تساهم بإعادة النظر الموضوعي والواعي في بعض الأحداث التاريخية والدينية بعيدًا من التخيلات التي شابها الكثير من أساليب الأساطير والخرافات.- الكلمات المفاتيح: إسلام، سيرة، آريوسية، مسيحية، مرويات شعبية**** باحث من لبنان، له العديد من المؤلفات والكتابات المنشورة
الحداثة (Al Hadatha) – س. 29 – ع. 224 - صيف 2022 SummerISSN: 2790-1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on September 21, 2022 04:53
September 11, 2022
محمد علي شمس الدين الصوفي الجنوبي ... وداعًا

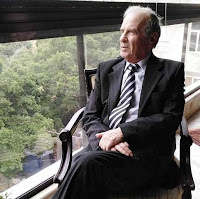
استراح الشاعر اللبناني محمد علي شمس الدين (1942 – 2022) بعدما طاف في عوالم الشعر لسنوات واكبها نزوح مستمر في الوطن بحثًا عن الوطن.شمس الدين الشاعر الذي غاص في التراث ليطلقه في عوالم الحداثة، ورحل في كشوفات الصوفية ليجعل منها صوفية تنتمي إلى جنوبه اللبناني الذي أحب حتى الرمق الأخير. بولادته الشعرية في بدايات السبعينيات من القرن العشرين، رسم شمس الدين صورة جديدة للذاكرة، وللذوق الأدبي ليس في لبنان فحسب، بل في الذاكرة الأدبية العربية أيضًا.نذكر في مجلة الحداثة ودارها وحلقة الحوار الثقافي تلك اللقاءات الممتعة والغنية معه وهو يقدم زبدة ما عنده من أشعار وأفكار تمسّ جوهر أوجاع الناس لتطال أحلامهم المجهضة بوعود وأوهام تعبر عن الانفصال الكامل بين السياسة اللبنانية وحاجات الناس وهمومهم. كذلك نذكر كتاباته غير مرة في مجلة الحداثة ومنها تقديمه مختارات من الشعر اللبناني والعربي المعاصر في عدد ربيع 1998، كذلك نشرت دار الحداثة أول كتاب له يحمل سيرته وهو بعنوان كتاب الطواف (1987).محمد علي شمس الدين الذي ترك أثرًا لا يمحى في الثفافة والوجدان العربيين، لن نقول وداعًا بل نلتقي معك كل صباح، ونحن نقرأ أعمالك الشعرية والنثرية التي ستبقي خالدة بخلودك في الذاكرة الأدبية اللبنانية والعربية.فرحان صالحرئيس تحرير مجلة الحداثة وأمين عام حلقة الحوار الثقافيبيروت في 11 أيلول/سبتمبر 2022الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on September 11, 2022 01:15
•
Tags:
alhadatha, مجلة-الحداثة
August 28, 2022
L’intervention psychologique dans une grossesse par transplantation utérine: la maternité dans une relation mère-fille

♦ Eliane Jean Haddad *
نبذة عن البحث باللغة العربية:الدعم النفسي للحمل عن طريق الزراعة
دراسة حالة في مستشفى جامعي لبناني
يميل اللجوء إلى معالج نفسي، إلى الحاجة الأساسية لعلاج الجسد من الألم؛ فالاستماع إلى الألم بطريقة فردية، له طابع وصدى مختلف عند كل شخص.أما الحالة المعالجة في هذه الدراسة، فهي إحدى الحالات الناجحة لزرع الرحم نُفذت في لبنان في مستشفى جامعي من قبل مجموعة أطبَاء وباحثين لبنانيين وسويديين على امرأة وُلدت وتكوَنت مع رحم طفولي، ثم نُقل رحم أمها إليها كي تحمل جنينها، وتنجبه من أحشائها.الدعم النفسي يجمّل الأشخاص المعنيين كطالبة الرحم وأمَها وزوجها، ويساهم بتنظيم العواطف والانفعالات المنبعثة من الضغط النفسي، ويحدّ من المخاوف في مواجهة فشل العملية الطبية، ومن ترجمة الأفكار الموروثة، والمعتقدات المتجذّرة المتناقلة بين الأجيال، فيعطي هذا الدعم، المعنى الحقيقي للعمل الجراحي الذي يهدف إلى تجميل واقع حياة المرء، وليس لإنقاذها من مرض ما فحسب.الكلمات المفاتيح: الدعم النفسي، الحمل، زراعة الرحم، دراسة حالة***
- Abstract: Le recours au psychologue tend à inscrire sa profonde nécessité dans le traitement du corps en souffrance. Ecouter la douleur dans sa singularité, résonne différemment d’une personne à l’autre. Le cas suivi dans cette étude est un des premières réussites de transplantation d’utérus, effectuée au Liban, dans un hôpital général par un groupe de chercheurs et médecins libanais et suédois, sur une femme née avec un utérus infantile, qui a reçu celui de sa mère afin de porter son enfant et le mettre au monde. L’accompagnement psychologique couvre le vécu de chacune des personnes impliquées: la receveuse, la donneuse et l’époux, dans le but de réguler les émotions ressenties, de calmer l’anxiété dûe au stress et la peur menaçante de l’échec médical, l’interprétation des idées reçues et des croyances rigides incrustées depuis les générations et donner sens à cet acte chirurgicale lourd qui a pour but d’embellir la vie d’une personne et non pas de la sauver d’une maladie.- Mots clés: L’intervention psychologique, Grossesse, Greffe utérine, étude de cas***La maternité, étant un vécu plein d’émotions, est ressentie par la femme depuis son jeune âge. La construction de cette quête de la féminité commence chez la petite fille avec le désir inconscient d’identifications préœdipiennes émanant du désir de ressembler à la mère voire l’imiter. En enfantant, la femme rejoint sa propre mère et la prolonge en se différenciant d’elle (Bydlowski, 2008).Freud a laissé dans notre psychè une forte empreinte de sentiment d’infériorité chez la fille selon sa théorie de la castration (Freud, 1987), ou l’incontournable absence de phallus entrainant un manque chez la fille à la découverte de la différence anatomique des sexes.Selon la Fédération Internationale de Gynécologie et d’Obstétrique, L’absence d’utérus ou syndrome de Rokitanski, est une anomalie rare qui touche une petite fille sur 4500 et est souvent détectée à l’adolescence par l’absence de règles (FIGO, 2009). L’absence d’utérus est un handicap discret mais qui peut peser lourd dans la vie d’une femme et causer beaucoup de souffrance. Ce problème est considéré comme une trahison suscitant un sujet d’angoisse. L’angoisse mobilise immanquablement cette appréhension du corps menacé dans son intégrité.- Etymologie et Définition des concepts:Utérus: Le mot «utérus» est issu du mot grec «hyster» ou «hustera», apparenté au latin «hystera» pouvant signifier la matrice, les entrailles. C’est le lieu de la nidation. L’utérus symbolise le foyer et la famille. Un problème à ce niveau trouvera souvent sa cause dans ce qui représente notre nid, le foyer, la famille (Doctissimo, mis à jour le 19/11/2018).Maternité: devenir mère «être parent pour la première fois implique de renoncer à sa propre position d’enfant, d’en finir avec l’idéalisation parentale» (Bydlowski, 2008). Être une bonne mère, c’est être une mère suffisamment bonne, selon Winnicott la mère parfaite n’existe pas.Complexe de castration: crainte immotivée de perdre l’intégrité de son corps. Le plus souvent il survient chez l’enfant à partir d’un sentiment de culpabilité, en rapport avec le complexe d’œdipe, et de la découverte de la différence anatomique des sexes. La fille envie le pénis du garçon et cherche les moyens de réparer le manque dont elle souffre. Avoir un enfant est l’un de ces moyens (Rycroft, c. 1982).Image du corps: est une expression psychologique pour la conception qu’on a de son propre corps (Freud, 1986). Le Moi corporel est un terme employé par Freud pour designer cette partie du Moi qui provient des autopercetions du Self, par opposition aux perceptions des objets externes.(...)***
* د. إليان جان الحداد: معالجة نفسية، وأستاذة مساعدة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية (الفرع 2) – الجامعة اللبنانية* Eliane Jean Haddad: Is a Psychotherapist & Assistant Professor at Faculty of Letters and Human Sciences (Branch 2) - Lebanese University.
الحداثة (Al Hadatha) – س. 29 – ع. 224 - صيف 2022 SummerISSN: 2790-1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on August 28, 2022 08:11
August 27, 2022
ظاهرة الزار ما بين الدراما الطقسية الشعبية والدراما الأكاديمية

♦ إكرام حامد الأشقر *
- نبذة عن البحث
يهدف هذا البحث إلى وضع إطار نظري أكاديمي للعناصر المكوّنة لرقصة الزار كممارسة طقوسية لها نظامها وترتيبها وشعائرها وأدواتها الطقوسية، كما يهدف إلى تسليط الضوء على الزار كفن شعبي من ناحية شكله وعناصره ودوره ووظيفته، ولا يمكن الوصول إلى أهداف الزار إلا عن طريق المكوّنات الجمالية بما يرافقه من أغانٍ ورقص وموسيقى، فهذا الأمر يمنح الحاضرين في الزار، الإيحاء الذاتي في ظل المعتقدات الشعبية إذ فيه تحصل النفس على أكبر قدر ممكن من الإثارة النفسية والانفعالية والجسدية، وذلك في جوّ احتفالي صامت يحدث فيه نوع من التطهير من الكبت الانفعالي والنفسي بهدف إحداث شكل من أشكال التوازن النفسي الذي يساعد على الإقبال على الحياة.- الكلمات المفاتيح: الزار، رقص شعبي، طقوس، دراما، فنون***انبثق الرقص من نشاطات الناس ليعبر عنهم في الأعياد والاحتفالات المختلفة، فهو يعكس الأحوال التي يعيشونها، وتلحظ الباحثة نادية الدمرداش أن الرقص الشعبي يعدّ من أقدم أنواع الفنون، إذ إنه ولد بمولد الإنسان، فعبّر عن أحزانه وأفراحه، وهو نوع من أنواع الفنون الشعبية، يعبر بصدق عن مشاعر الشعوب ويحكي تاريخها ويحتفظ بتراثها ويتوارثه الأجيال، ويرقصه جميع أفراد الشعب على اختلاف طبقاتهم ومستوياتهم الاجتماعية والثقافية.1ويشمل الرقص الشعبي الثقافة الروحية والمتوارثات الشفهية لشعب معين، فيتضمن المشاعر والأحاسيس والتقاليد والأعراف التي خلفها السلف في كل طقوس الحياة.2 ومن ذلك، تعبير الرقص الشعبي بوحدات الحركة عن رد فعلي جمعي لدورات الحياة المهمة، ولا شك أنه يقوم اليوم بدور مهم في الاحتفالات في جميع أنحاء العالم، ففي المجتمع المتحضر يرقص الناس للتسلية، أما في المجتمع البدائي فكان يرقص أفراد القبيلة استرضاء للآلهة وقوى الخير، ويتخذون من الرقص وسيلة لطرد الأرواح الشريرة. وللرقص الشعبي وظائف عالمية تختلف باختلاف المناخ والظروف الجغرافية وتنوع الأمزجة، ولكل قارة وأمة وقبيلة أسلوبها الخاص بها في الرقص.3استخدمت الشعوب القديمة الرقص في معظم نواحي الحياة: في تقديم القرابين، وفي السحر والعبادة، وحفلات الولادة والجنائز والصيد والمرض والحصاد.4 ويلحظ أن العناصر التي تميز الرقص الشعبي عن غيره هي ما يحمله بداخله من عناصر الثقافة الشعبية، ومن مأثورات وتراث شعبي يلازم جميع مناسبات دورة الحياة الإنسانية.5 وتعدّ الطقوس في العرف اللغوي، النظام والترتيب الخاص بإقامة الشعائر بمظاهر وأدوات معينة، فالرقص الطقوسي يؤدى وفقًا لشعائر أو مبادئ معينة، وتصاحبه أعمال وأدوات تقليدية منه الرقص الديني والجنائزي، ورقصة الحرب التي تعدّ أقدم أنواع الرقص التاريخي، وهي ما نراها مصورة على جدران المعابد.6في كل ممارسة طقوسية هناك علاقة بين الرقص والطقوس؛ فالرقص ليس مجرد تسلية بسبب رغبة ملحة، لكنه كان يحتوي على مغزى سحري، وهو يظهر كحركات إيقاعية للجسم، والطقوسية ممارسة تعبدية رمزية تعبر عن نفسها بمظاهر وسلوكيات جسدية محددة ناتجة عن حركات تعبيرية إيمائية، أي بما هي لغة جسدية أو جهاز جسدي تقني يبثّ عضويًّا رسائل معينة.7وفي الرقص الطقوسي يتدخل العامل الديني أو السحري، ويستخدم كعامل أساسي في الرقص لمحاربة قوى خفية والانتصار عليها. وقد يكون الهدف من الرقص الطقوسي خلق شحنة انفعالية لدى المشاهد كما في رقصات الدراويش حيث يقصدون إلى الصفاء الروحي، والتقرب إلى الله وبعث الشعور الديني في نفوس المشاهدين.8أما الرقص الصوفي فهو ذاكرة النفس المضيئة، لأنه ليس مجموعة حركات تم ضبطها وتنظيمها من الخارج، بل هي مرتبطة بفاعلية الكائن الأسمى، وهو يؤكد تلاحم وتفاعل كل المعاني المؤكدة لإنسانية الإنسان ماضيًا وحاضرًا ومستقبلًا. والرقص الصوفي هو محاولة حماية الجسد وتحصينه والوصول به إلى التطهير (الكاتارسيس) من كل ما هو مادي يغلق على النفس.9 ويتسم الرقص الشعائري بأنه يهتم باللفتات والتطويعات السريعة حيث يعتقد أنها تخلص الإنسان من الأرواح الشريرة، وتبعدها من التأثير فيه.10(...)***
* باحثة من لبنان، دكتورة في كلية الفنون والعمارة، الجامعة اللبنانية
1- الدمرداش، نادية وإبراهيم، علا، مدخل إلى علم الفولكلور (دراسة في الرقص الشعبي)، دار عين للدراسات والبحوث 2003، كذلك: السيد، عبير، في الرقص والرقص الشعبي، مجلة الحداثة فصلية محكمة، الثقافة والفنون في زمن العولمة، بيروت، السنة التاسعة، عدد 69-70، ص 140
2- الأشقر، إكرام، الرقص لغة الجسد، دار الفرات، ط.1 2003، بيروت، ص 59
3- عبد الرحيم، أحمد محمد، الرقص الشعبي في مصر، الحداثة مجلة فصلية محكمة، بيروت 1995، العددان التاسع والعاشر، ص 182
4- السعيد، فاطمة عبد الحميد، الأسس العلمية والتشريحية لفن الباليه، تقديم نفيسة الغمزاوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1973، ص 12
5- السيد، م. س.، ص 140
6- العليمي، عادل، الزار ومسرح الطقوس، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1993، ص 106
7- دكروب، محمد، محاضرات، معهد العلوم الاجتماعية الفرع الأول، دبلوم، العام الدراسي 94 و95
8- محمد، عايدة عبد العزيز، العادات والتقاليد وأثرها في الفن الشعبي كما يجسدها الزار، كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان، رسالة ماجستير، ص69
9- الأشقر، م. س.، ص 134
10- محمد، م. س.، ص69
الحداثة (Al Hadatha) – س. 29 – ع. 224 - صيف 2022 SummerISSN: 2790-1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on August 27, 2022 02:31
August 25, 2022
تاريخ العلاقات الكردية – العربية والوجود الكردي في لبنان تاريخًا وراهنًا

♦ صلاح عصام أبو شقرا *
نبذة عن البحث
يعدّ الأكراد من ضمن الأقليات الإثنية التي وفدت إلى لبنان منذ قرون بعيدة حتى ما بعد تأسيس دولة لبنان الكبير. فقد توالت الهجرات الكردية إلى لبنان خلال ثلاث حقبات، أولها هجرة قديمة من فترة الغزوات الصليبية، الثانية قديمة أيضًا، شملت عائلات باتت من صلب المجتمع اللبناني منذ ما قبل تأسيس دولة لبنان الكبير، بل وبعضها يتصدر واجهة العمل السياسي في مناطق تواجد تلك العائلات، والثالثة حديثة وتشمل الأكراد القادمين إبتداءً من عشرينيات القرن الماضي، أي بعد تأسيس دولة لبنان الكبير. وتبرز هذه الورقة البحثية دور الأكراد في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في لبنان على الرغم من حرمانهم من الجنسية اللبنانية.بالنسبة إلى الحقبة الأولى، فقد تمثلت بقدوم الأيوبيين، وهم من أكراد تكريت في العراق،[i] إلى جبال لبنان لحماية الثغور من الحملات الصليبية في القرن الثاني عشر، كما أكد الشدياق[ii] أنهم أكراد وتمركزوا في منطقة من شمال لبنان، هي قضاء الكورة حاليًا. وهناك أثر بالغ الأهمية للأكراد الأيوبيين في شمال لبنان هو قلعة المسيلحة،[iii] في أسفل وادي نهر الجوز في قضاء البترون. وما زال أحفاد الأيوبيين يحتفظون بلقب أمراء ويقيمون في بلدة "راسنحاش" في قضاء البترون.أما بالنسبة إلى الحقبة الثانية، فقد تجسدت بقدوم العائلات الكردية التي أدت دورًا مهمًا في كتابة تاريخ لبنان أبرزها سيفا، ومرعب، وجنبلاط، والعماد، وعدد من العائلات الأخرى.بنو سيفا الأمراء الأكراد الذين عين منهم الأمير يوسف واليًا على طرابلس سنة 1579،[iv] كذلك يؤكد حتي[v] أن آل سيفا من أصل كردي، انتقل إليهم الحكم من آل عساف وقد اتخذوا من طرابلس مركزًا لهم.المراعبة، من الشائع أنهم من أصول كردية،[vi] وقد ذكر أنهم من بكاوات منطقة هكاريا في جنوب شرق تركيا الحالية، أي كردستان الشمالية. علمًا أن المراعبة هم زعامة تاريخية في محافظة عكار[vii] وبقي تمثيلها في البرلمان إلى زمن قريب جدًا.الجنبلاطيون، فقد أجمع عدد من المؤرخين على أصولهم الكردية، وأبرزهم الصليبي،[viii] الذي أشار إلى أن آل جنبلاط من أصول كردية وتولوا إيالة حلب. كما أوضح حتي[ix] أن علي باشا جانبولاد تولى ولاية حلب وتحالف مع الأمير اللبناني فخر الدين المعني، وكذلك المؤرخ المصري عبد العزيز عمر[x] الذي ذكر أن علي باشا جانبولاد كان أمير كلس وهو كردي. وقد يكون سبب وفودهم إلى جبل الدروز (جبل لبنان الجنوبي حاليًا) هو تلك العلاقة المتينة مع الأمير فخر الدين الثاني.كذلك آل العماد، تلك العائلة الإقطاعية التي اشتهر منها عبد السلام يزبك العماد، وتنسب الزعامة اليزبكية له. وتعود أصول العماديين بدورهم إلى الأصل الكردي، وأكد الهشي[xi] أن لهم صلة قربى بعماد الدولة الديلمي الكردي، الذي حكم العمادية. وقد تزعمت هاتان لعائلتان دروز وموارنة، جبل الدروز[xii] لفترة طويلة، وتنافستا تحت مسمى الحزبية الجنبلاطية – اليزبكية. وما زالت العائلة الجنبلاطية تمثل ما يفوق ثلثي دروز لبنان إلى يومنا هذا.لا يقتصر وجود أكراد الحقبة الثانية على العائلات المذكورة آنفًا، بل هناك عدد كبير من العائلات المنتشرة في معظم المناطق اللبنانية تعود أصولها إلى الكرد، نذكر منها: آل حمية في طاريا – قضاء بعلبك، كذلك آل مشيك المنتشرون في عدد من بلدات وقرى القضاء وفي قضاء الشوف – جبل لبنان هناك عائلتا نصر الله وأبو غانم اللتان يرجح أنهما من العائلات الكردية التي رافقت آل جنبلاط في هجرتهم إلى جبل الدروز.أما الحقبة الثالثة من الهجرة إلى لبنان، فقد بدأت في عشرينيات القرن العشرين نتيجة حملات الإخضاع لسياسة التتريك والتي تخللها أعمال إبادة وترهيب، فضلًا عن التدمير لمحو الذاكرة الكردية من أي أثر لمعالم وطنهم وأصل هويتهم، وكان ذلك على أثر ثورة الشيخ سعيد البيراني سنة 1925 حيث قامت السلطات التركية بقيادة مصطفى كمال "آتاتورك" بقمعها بطرق وحشية في ديار بكر. كما وفد في تلك الحقبة أيضًا الأكراد من ولاية ماردين.عاش الأكراد في لبنان لفترة طويلة من دون جنسية لبنانية، حين كان أكثرهم من حملة بطاقة "قيد الدرس" أو "مكتوم القيد". وقد تأخر تجنيسهم في لبنان حفاظًا على التوازن الطائفي الذي أقرته صيغة ميثاق 1943، بينما حصل على الجنسية اللبنانية عدد من اللاجئين إلى لبنان كالأرمن، والأشوريين، والكلدان، والسريان وغيرهم من الذين وفدوا في الفترة الزمنية نفسها.(...)**** باحث وأكاديمي لبنان. (مداخلة قُدمت في "مؤتمر الحوار اللبناني – الكردي، نحو عيش مشترك ومواطنة متساوية" - فندق بادوفا – سن الفيل، الأحد 29 – 5 – 2022)
[i]- الصليبي، كمال (1992)، منطلق تاريخ لبنان، ط. 2، بيروت: مؤسسة نوفل، ص: 107
[ii]- الشدياق، طنوس (1970)، أخبار الأعيان في جبل لبنان، الجزء الأول، بيروت: منشورات الجامعة اللبنانية، ص: 190
[iii]- الصليبي، كمال (1991)، بيت بمنازل كثيرة - الكيان اللبناني بين التصور والواقع، بيروت: مؤسسة نوفل، ص: 182
[iv]- الأسود، إبراهيم (1978)، تنوير الأذهان في تاريخ لبنان، ط.1، بيروت: دار الكتاب، ص: 340
[v]- حتي، فيليب (1972)، تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية إلى عصرنا الحاضر، ترجمة أنيس فريحة، ط.2 ، بيروت: دار الثقافة، ص: 451
[vi]- أحمد، أحمد (1955)، أكراد لبنان وتنظيمهم الاجتماعي والسياسي، ط.1، بيروت: مكتبة فقيه، ص: 50
[vii]- جذور تسمية عكار تعود إلى منطقة هكاريا في جنوب شرق تركيا، شمال كردستان.
[viii]- الصليبي، بيت بمنازل كثيرة، ص: 196
[ix]- حتي، تاريخ لبنان، ص: 454، 455
[x]- عبد العزيز عمر، عمر (1984)، تاريخ المشرق العربي المعاصر 1516 – 1922، بيروت: دار النهضة العربية، ص: 166
[xi]- الهشي، سليم (1983)، المراسلات الاجتماعية والاقتصادية لزعماء جبل لبنان خلال ثلاثة قرون 1600 – 1900، بيروت: مطبعة نمنم، ص:20
[xii]- اصطلح على تسمية المنطقة الجنوبية لسلسلة جبال لبنان الغربية، بجبل الدروز والتي كانت تتألف من جبلي صيدا وبيروت، الأول شمل حالياً قضاء الشوف، والثاني قضائي عالية، وبعبدا.
لحداثة (Al Hadatha) – س. 29 – ع. 224 - صيف 2022 SummerISSN: 2790-1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on August 25, 2022 04:41
August 22, 2022
كراهة العرب لتكرار الحرف وأثرها في الرَّسم الإملائي

♦ صونيا جرجس الأشقر *
نبذة عن البحث
حرَّم الإسلام تصوير التّماثيل، والأصنام، والأوثان، والأشكال المجسَّمة ذات الظِّلّ، والتي تدخل ضمن ذوات الأرواح. واستثنوا من ذلك ما يلهو به الطّفل كالعرائس وغيرها، كما أجازوا تصوير غير ذوات الأرواح، كالجبال، والأنهار، والشّمس، والقمر، والأشجار، كلّ ذلك بهدف إبعاد المسلمين عن الدّيانات الوثنيّة التي كانت شائعة في العصر الجاهليّ.([1])ولم يكن التّصوير بالخطّ من المحرّمات، فاتَّجهَ الفنّانون المسلمون نحوه يتفنّنون في أشكاله ولوحاته، فأوجدوا الخطَّ الكوفيّ، والفارسيّ، والنَّسخيّ، والدّيوانيّ، وخطوط الإجازة، والرّقْعة، والتّعليق،([2]) وأبدعوا فيها لوحاتٍ رائعة الجمال.([3])وجمال الخطّ خاصّةً، عندهم، تَجنُّب تكرار الحرف دون فاصل، وقد عبَّروا عن هذا التَّجنُّب بعبارة "تجنُّب توالي الأمثال"؛ ولم يوفَّقوا في هذه العبارة، لأنَّ الأمثال، في الخطّ، تعني الحروف ذوات الأشكال المتماثلة كالحروف: (ب - ت - ث)، والحروف: (ج - ح - خ)، والحرفين: (د - ذ)، والحرفين: (ر - ز)...لقد رأى العرب في تكرار الحرف مرَّتين أو ثلاث مرّات دون فاصل بشاعةً،([iv]) فكرهوا([v]) هذا التّكرار؛ ولذلك حرصوا على تجنُّبه. وظهر هذا الحرص في عناوين فصول كتبهم الإملائيّة، وفي العديد من القواعد التي وضعوها للخطّ. ومن هذه العناوين ما نجده في كتاب نصر الهورينيّ([vi]) "المطالع النّصريّة للمطابع المصريّة في الأصول الخطّيّة"، فقد عَنْوَن الفصل الخامس من باب الحذف هكذا: "فيما يحذف من الواوات المتكرّرة لفظًا فِرارًا من اجتماع المثْلين صورةً، وإن كانت إحداهما همزة لفظًا، وما لا يحذف منها عند اللَّبس".([vii]) وجاء عنوان الفصل السّادس من الباب نفسه هكذا: "في حروف أُخرى تُحذف للإدغام، أو لاجتماع الأمثال، وهي: اللّام، والتّاء، والنّون، والميم، والياء".([viii]) أمّا أثر الحِرْص على تجنُّب تكرار الحرف، أو على تجنُّب اجتماع الأمثال، بحسب تعابير اللّغويّين القدامى في الرَّسم الإملائيّ، فقد تجلّى في سبع عشرة مسألة...(...)***
* باحثة وصحافية لبنانية. حائزة شهادة دكتوراه في اللغة العربية وآدابها – الجامعة اللبنانية
([1]) عن الإنترنت، ويكيبيديا، تاريخ الدّخول في 5/4/2022.
([2]) انظر: إميل يعقوب، الخطّ العربيّ: نشأته تطوّره مشكلاته دعوات إصلاحه، ص 41 – 43
([3]) انظر: م. ن.، ص 119 – 140
([4]) راجي الأسمر: المرجع في الإملاء، ص 211
([5]) السّيوطيّ: همع الهوامع، 6/329، 332؛ ونصر الهورينيّ: المطالع النّصريّة، ص 86
([6]) أبو الوفاء نصر ابن الشّيخ نصر يونس الوفائيّ (ت1291ه/1874م): عالم بالأدب واللّغة، أزهريّ من أهل مصر. تولّى رئاسة تصحيح مطبوعات المطبعة الأميريّة. من مؤلّفاته: "المطالع النّصريّة"، و"شرح ديباجة القاموس"، و"مختصر روض الرّياحين للرّافعيّ" (الزّركليّ: الأعلام، 8/29).
([7]) نصر الهورينيّ: المطالع النّصريّة، ص 130
([8]) م. ن.، ص 131
الحداثة (Al Hadatha) – س. 29 – ع. 224 - صيف 2022 SummerISSN: 2790-1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on August 22, 2022 03:49
سيميائية الغزل عند زهرة الحر في ديوان "قصائد منسية"

♦ فاطمة أحمد شعبان *
نبذة عن البحث
يهدف البحث إلى تقصّي العلامات السّيميائيّة في شعر الشّاعرة اللّبنانيّة زهرة الحرّ (1917 - 2004)، من أجل تبيان سيميائيّة الغزل في ديوانها "قصائد منسيّة" الّذي صدر العام 1970، وقد عالجت فيه أمور الحياة وهمومها، وقد بلغت قصائد الديوان اثنتين وسبعين قصيدة، أما القصائد الغزلية موضوع البحث، فقد بلغت تسع عشرة قصيدة وردت بشكل متتالٍ في الدّيوان، وتمّت دراستها بالتّرتيب نفسه الّذي وردت فيه، والمتتبّع لها يكتشف قصّة حبّ وهجر ارتسمت أحداثها ومعالمها تدريجيًّا في ثنايا الأبيات، وكأنّ الشّاعرة بدأت قصّتها في "ظلال الأرز" لتنهيها في "الأهواء".وإذ يرصد البحث قصّة حبّ تظهر في مجموعة من القصائد الغزليّة، ويعالج محاور التّشاكل والصّراع ودور التّناص الدّينيّ في النّصّ، يطرح الآتي: هل زهرة الحرّ في كتاباتها عن الحبّ كتبت – وسط القيود الّتي كان يعيشها المجتمع العربي- بلسان المرأة أم بلسان المجتمع؟ وهل أفصحت الشاعرة عن مشاعرها تجاه "الحبيب" كأنثى أم بقيت العادات والتّقاليد قيدًا تحدّ من ذلك؟اعتمدنا لمعالجة موضوع البحث، آليّات المنهج السّيميائيّ، وقد برزت النّتائج من خلال ترابط المستويات في ما بينها، وعليه فإنّ هذا التّرابط كان له فاعليّة في الكشف عن رؤى الشّاعرة إلى الحبّ، وإلى القدر والفناء.- الكلمات المفتاحيّة: زهرة الحرّ، السّيميائيّة، الغزل، قصائد منسية***Study SummaryThe research aims towards investigating the semiotic signs in the poetry of the Lebanese Poet Zahra Al Hor (1917- 2004) for the purpose of clarifying the semiotic flirtations in her divan "Forgotten Poems" which was published in 1970. She dealt in it with life issues and its troubles, and the poems have reached 72 poems. Concerning the flirtatious poems which are our concern, they have reached 19 poems in a successive manner in the divan. They have been examined in the same order they appeared in the divan. Moreover, the one who is examining them, can discover a love and abandonment story that appears gradually among the stanzas as if the poet started her story in "Cedars Shadows" to end it in the " Whims". Although the research examines a love story which appears in a set of flirtatious poems, and it deals with themes about problems, struggles, and the role of religious intertextuality in the text, it suggests the following:Did Zahra Al Hor in her writings about love write _ within the restrictions which the Arabic society was living in_ in the tongue of women or society? And did she reveal her feelings towards "the beloved" as a female or did the customes and traditions constraint that? We have adopted in our research the mechanisms of the semiotic method and the results appeared through the relations of the levels among them. Thus, this bonding had its effectiveness in revealing the poet's insights towards love, fate, and death.
***يتجلى الصّراع في الشّعر من خلال ما تتنبّأ به دلالات الألفاظ؛ فالنّصّ الشّعريّ قادر على تقديم رؤية عميقة لواقع صاحبه، فزهرة الحرّ شاعرة من جبل عامل، ولدت في صور العام 1917م، والدها الشّيخ "جواد الحرّ" من جباع الحلاوة (إقليم التّفّاح)، وهي تنتسب إلى عائلة شيعيّة عريقة ومشهورة متمسّكة جدًّا بالتّقاليد والعادات الموروثة، وقد أنجبت هذه العائلة العلماء والفقهاء والأدباء والشّعراء.[i] بدأت الحرّ بقرض الشّعر وهي في الثّالثة عشرة من عمرها، وعندما أصبحت شابّة، أسهمت إلى حدّ كبير في حركة تحرير المرأة في منطقة "جبل عامل" وهي منطقة لها ما لها من الأهمّيّة في عمليّة الصّمود ضدّ العدوان الإسرائيليّ المتكرر على جنوب لبنان، شعرها رومانسيّ ثائر يجسّد العواطف الجيّاشة والحسّ المرهف. حازت الحرّ وسام العمل الفضّيّ من رئاسة الجمهوريّة اللّبنانيّة بعد نشر ديوانها "قصائد منسيّة"، كما منحها المجلس الثٌّقافيّ لجنوب لبنان وسام المجلس اعترافًا لها بمشاركتها في تأسيسه.[ii] وكغيرها من النّساء في العالم العربيّ، دخلت الحرّ المدارس في وقت متأخّر عن الرّجل، فاستهواها الشّعر، فنظمته معبّرة عن وجدانها، وأفرغت فيه ما يضنيها وما يفرحها، فكان عندنا شّاعرة، لكنّها لم تنل الحظّ الوافر من شيوع شعرها. ولعل سبب ذلك، ما يشير إليه الباحث اللبناني أنيس مقدسيّ (1885 – 1977)، إذ يلحظ أن إبداع المرأة العربية الشّعريّ "لم ينل حظّه من الاهتمام، فكان وما زال أقلّ شأنًا في تاريخ الأدب العربيّ، ولكنّه مع مرحلة بعث النّهضة.... أدركت المرأة المتعلّمة كما أدرك الرّجل، أنّ لها حقوقًا ضائعة وأنّه من الواجب أن نفتح لها أبواب التّقدّم".[iii]أما الباحث الفلسطيني رجا سمرين (1929 – 2018) فيؤكد أن المرأة الشّاعرة "ظلّت مغبونة في الدّراسة، وأدب المرأة عمومًا وفي مختلف العصور قد لقي من إعراض الباحثين والمؤرّخين ما لا ينبغي أن يلقاه".[iv]ويقول الباحث اللبناني قيصر مصطفى (1943) في حديثه عن الشّاعرات: "كنّ معظمهنّ من المقلاّت"،[v] إلاّ أنّه عاد وذكر أنّ "بعضهنّ تمكّنّ من البروز والتّغلّب على الحواجز الاجتماعيّة والمثل الأخلاقيّة، ومن هؤلاء زينب فوّاز وزهرة الحرّ".[vi]في هذا المجتمع عاشت زهرة الحرّ فراحت تتحدّى القيود المفروضة على المرأة لتكون شاعرة على السّاحة اللّبنانيّة، واستطاعت أن تثبت نفسها على السّاحة الشّعريّة ما يقارب ربع قرن بين كبار الشّعراء العامليّين، في الوقت الّذي لم يكن يسمح فيه للفتاة بالخروج ولو في سبيل العلم.[vii] وكما كان لشعر المناسبات حضور قويّ في شعر الحرّ، كان لشعر الغزل نصيب وافر، لكنّ الشّاعرة عاشت صراعًا بين ما ترغب فيه وبين الواقع الذّي تحياه فكان الشّعر الملاذ الّذي تلجأ إليه.وعن تعريف السّيميائيّة فيمكن تلخيصها بدراسة حياة العلامات داخل الحياة الاجتماعية،[viii] وهي في حقيقتها "كشف واستكشاف لعلاقات دلاليّة غير مرئية". فالدّراسة السّيميائيّة تغوص في أعماق النّصوص، وتستكشف مدلولاتها الدّاخليّة المحتملة، مع محاولة ربط النّص بالواقع، والسّيميائيّات لا تنفرد بموضوع خاصّ بها، فهي تهتمّ بكلّ ما ينتمي إلى التّجربة الإنسانيّة العاديّة شريطة أن تكون هذه الموضوعات جزءًا من سيرورة دلاليّة.وفي هذه الدّراسة، نحاول تقصّي العلامات السّيميائيّة ودلالاتها، والعلاقات الّتي فرضت نفسها بين الشّكل والمضمون، ما أفضى إلى تجلّي الغزل عند المرأة الجنوبيّة العامليّة في عصر الحداثة، ونكشف عن طبيعة العلاقة الّتي جمعت الحبيبين في قصائد الحرّ، لتبيان إن كانت هذه العلاقة نفسها أم اختلفت من قصيدة إلى أخرى، ولإظهار إن كانت المرأة العامليّة على الرّغم ممّا وصلت إليه من مراتب علميّة ومراكز اجتماعيّة قد استطاعت أن تكسر قيودًا فرضتها العادات والأعراف، ولتبيان موقف الشّاعرة من كلّ هذا، وللكشف عن رؤيتها إلى الصّراعات المتجلّيّة في القصائد. كلّ ذلك من خلال تحليل العلامات اللّغويّة على عدّة مستويات. فالنّصّ الشّعريّ لا حدود لدلالاته، وتبقى مهمّة المتلقّي أن يدرس هذه العلامات لينتج العلاقات الّتي فرضت نفسها بين المحاور الّتي ستظهر لنا.وإذا كانت القراءة السّياقيّة قد يمّمت وجهها شطر الخارج تحاور حقوله المختلفة، فإنّ الدّراسة ستوكل لنفسها مهمّة الغوص في مجاهل عالم مغلق تقرّ بوجوده واستقلاله وتعطيه سمات الكائن الحيّ ذي الخصائص المميّزة.[ix]تنطلق الدّراسة السّيميائيّة من العنوان الّذي يمارس ضغوطه على المتلقّي، ومن خلاله تتأسّس فاعليّة المتلقّي، ونقصد هنا عنوان الدّيوان وعنوان القصائد الّتي تمّ اختيارها.(...)*** * باحثة وتربويّة لبنانية، تعدّ أطروحة في اللّغة العربيّة وآدابها- المعهد العالي للدّكتوراه- الجامعة اللّبنانية
[1]- خديجة شهاب، زهرة الحرّ شاعرة جبل عامل، دار البنان، لبنان 2011، ط1، ص45
[2]- إحسان هندي، أشهر شاعرات الحبّ في بلاد الشّرق والغرب (تراجم ومختارات شعريّة) القسم الثّاني، آفاق ثقافيّة، منشورات الهيئة العامّة السّوريّة للكتاب، دمشق، ع. 113، أيلول 2012، ص110
[3]- أنيس المقدسي، الاتجاهات الأدبيّة في العالم العربيّ الحديث، دار العلم للملايين، بيروت 1960، ط2، ص252
[4]- رجا سمرين، شعر المرأة العربيّة المعاصرة 1945-1970، دار الحداثة، بيروت 1990، ط1، ص 6
[5]- قيصر مصطفى، الشّعر العامليّ الحديث في جنوب لبنان (1900- 1977)، رسالة دكتوراه في النّقد والأدب، إشراف الدكتور أحمد الشّرباصي، القاهرة 1978، ص 133
[6]- زينب مرعي الضّاوي، فاصلة بين الماء والنّار، جمعيّة أصدقاء الكاتب والكتاب، بيروت، لا ت، لا ط، ص 5
[7]- كامل صالح، مفهوم المعاصرة في شعر نزار قباني – (ديوان قالت لي السمراء 1944)، مجلة الحداثة، بيروت، ع.31/34، ربيع 1998، (من ص 20 إلى 24)
8 - سعيد بنكراد، السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها، دار الحوار للنّشر والتّوزيع، سوريا، ط3، ص9
[9]- ليلى شعبان شيخ محمّد رضوان، سهام سلامة عبّاس، المنهج السّيميائيّ في تحليل النّصّ الأدبيّ، حوليّة كلّيّة الدّراسات الإسلاميّة والعربيّة للبنات بالإسكندريّة، المقالة 9، المجلد 33، ع.1- الرقم المسلسل للعدد 9، 2017، ص 781
الحداثة (Al Hadatha) – س. 29 – ع. 224 - صيف 2022 SummerISSN: 2790-1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on August 22, 2022 03:42
•
Tags:
alhadatha, مجلة-الحداثة
August 21, 2022
المبشّرات في الإسلام وموجباتها
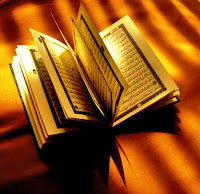
♦ حسين محمد قاسم *
نبذة عن البحث
قد تعتري الإنسان حالات من الإحباط بسبب ما يحصل معه من أحداث مؤلمة، وبما أن الأمة اليوم مفككة، بينما ترزح الشعوب في كثير من أقطارها تحت خط الفقر، وهي ترى الغرب يستولي على كثير من خيراتها، فهذا ما يدخل اليأس إلى كثير من النفوس فتأتي المبشرات لتزيل هذا اليأس.
- تعريف المبشرات:
بشَره بالأمر يبْشُره بَشْرًا وبُشورًا وبُشْرًا، وبشَره به بشْرًا، وبشَّره وأبْشَره فبشِرَ به، يقال: بشَّرته فأبْشَر واستبشر وتبشَّر وبَشِرَ: فرِح. وفي التنزيل العزيز: ﴿فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ﴾ [التوبة: 111]، وفيه أيضًا: ﴿وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [فصلت: 30]، والبشارة المطلقة لا تكون إلا بالخير، وإنما تكون بالشر إذا كانت مقيدة، كقوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الانشقاق: 24]. والاسم: البشرى والبِشارة والبُشارة، والبشارة اسم لكل ما يدخل الفرح والسرور في القلب، والجمع: مبشرات وبشارات وبشريات وبشائر وتباشير.([i])(...)***
* باحث فلسطيني من مواليد لبنان، دكتور في أصول الفقه، مدرس في كلية الدعوة، وفي جامعة الجنان
[i]- ابن منظور، محمد بن مكرم: لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط3، 1414ه، 4/61. مادة: ب ش ر. بتصرف.
الحداثة (Al Hadatha) – س. 29 – ع. 224 - صيف 2022 SummerISSN: 2790-1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on August 21, 2022 13:45
August 18, 2022
إشكالية القرار رقم 60 ل.ر. لدى الطائفة الإسلامية في لبنان

♦ فرح أمين القوزي *
- ملخص البحث
تعالج هذه الورقة البحثية قرار المندوب الفرنسي رقم 60 ل.ر. للعام 1936 والذي أصبح في ما بعد، حجر الأساس في النظام الطائفي اللبناني؛ ففي حين وافقت عليه الطائفة المسيحية، تمنعت الطائفة الإسلامية عن ذلك من خلال موقف مفتي الجمهورية اللبنانية آنذاك الشيخ محمد توفيق خالد (1874 - 1951م)، على اعتبار أن الديانة الإسلامية كفلت الحقوق الاجتماعية كافة، وأن أي تعديل سيطرأ إنما يمسّ جوهر الشريعة الإسلامية ما حدا بالمفوض السامي، التراجع عن فرضه تجاه الطائفة الإسلامية التي استطاعت في نهاية المطاف أن تكوّن مؤسساتها الروحية المستقلة إداريًّا عن سلطة الدولة.- الكلمات المفاتيح: لبنان، الانتداب، الطائفة الإسلامية، 6 و6 مكرر*** وجدت الأديان في الأصل، من أجل حماية الإنسان لا لتعقيد حياته، فمن المفترض في بلد كلبنان موطن الأديان والشرائع والقوانين، أن يرعى العهود ويفي بالتزاماته تجاه مواطنيه في التعاملات اليومية، لاعتبارها واجبًا وطنيًّا، ومؤشرًا مهمًا يجعل من انتماء الإنسان اللبناني إلى بلده أقوى من انتمائه إلى طائفته.من هنا، ساهم موقع لبنان وطبيعته الجغرافية، في تكوين شخصية مورفولوجية ميّزَتْهُ عن جيرانه، وجعلته موطئًا للتلون الطائفي والمذهبي. فعانى من "أزمة جمود وركود" (ناصر، 2001، صفحة 25) حتى عُدّ المجتمع اللبناني من المجتمعات الطائفية الجامدة، مشكّلاً عقبة في سبيل بروز تنظيمات جديدة لملائمة حاجاته الاجتماعية المتغيرة (قباني، 1983). فتمركز النظام الطائفي "رسميًّا وصراحة" في لبنان، ليصبح قاعدة تقليدية لحياته السياسية، ومركزًا إلزاميًّا لأحوال أبنائه الشخصية. ومع انتشار الأفكار والعادات الغربية، برزت الحاجة إلى تحديد الأحكام العائدة للأحوال الشخصية باعتماد مبدأ المساواة بين الذكر والأنثى، والاقرار بحقّ التمثيل لورثة المتوفى في تركة موروثة، وهما الوضعان اللذان لا توفرهما الشريعة الإسلامية (رباط، 1970).(...)***
* باحثة لبنانية – تعدّ أطروحة دكتوراه في التاريخ السياسي والعلاقات الدولية - المعهد العالي للدكتوراه - الجامعة اللبنانية
الحداثة (Al Hadatha) – س. 29 – ع. 224 - صيف 2022 SummerISSN: 2790-1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on August 18, 2022 02:29
مجلة الحداثة - Al Hadatha Journal
Al Hadatha Journal - A Refereed Academic Quarterly
مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة
تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)
ISSN/2790 Al Hadatha Journal - A Refereed Academic Quarterly
مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة
تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)
ISSN/2790-1785
تُعنى المجلة بنشر الأبحاث الأكاديمية بعد عرضها على لجنة علمية متخصصة. وتبلورت فكرة نشوء المجلة بعد اجتماعات عمل متواصلة بين رئيس تحريرها فرحان صالح وأصدقاء باحثين وأكاديميين من لبنان والعالم العربي، وقد بات عدد منهم ضمن الهيئة الاستشارية للمجلة، علمًا أن بعضهم قد فارق الحياة، وقد جرى إضافة أسماء إلى الهيئة لاحقًا. تغطي مجلة الحداثة الأبحاث التي تأتي من شريحة واسعة من الأكاديميين والمفكرين والكتّاب والأدباء في لبنان والعالم العربي، فتنشر موضوعات تتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والسياسية، كذلك، موضوعات تتعلق بقضايا فكرية وتراثية وأدبية ونقدية وفنية وإعلامية ...more
مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة
تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)
ISSN/2790 Al Hadatha Journal - A Refereed Academic Quarterly
مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة
تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)
ISSN/2790-1785
تُعنى المجلة بنشر الأبحاث الأكاديمية بعد عرضها على لجنة علمية متخصصة. وتبلورت فكرة نشوء المجلة بعد اجتماعات عمل متواصلة بين رئيس تحريرها فرحان صالح وأصدقاء باحثين وأكاديميين من لبنان والعالم العربي، وقد بات عدد منهم ضمن الهيئة الاستشارية للمجلة، علمًا أن بعضهم قد فارق الحياة، وقد جرى إضافة أسماء إلى الهيئة لاحقًا. تغطي مجلة الحداثة الأبحاث التي تأتي من شريحة واسعة من الأكاديميين والمفكرين والكتّاب والأدباء في لبنان والعالم العربي، فتنشر موضوعات تتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والسياسية، كذلك، موضوعات تتعلق بقضايا فكرية وتراثية وأدبية ونقدية وفنية وإعلامية ...more
- مجلة الحداثة's profile
- 11 followers



