مجلة الحداثة's Blog: مجلة الحداثة - Al Hadatha Journal, page 14
May 17, 2022
ثورات الربيع العربي بين العفوية واستراتيجية القوة الناعمة

♦ زينه إبراهيم حبلي *
- نبذة عن البحث

شهدت المنطقة العربية منذ مطالع العام 2011 "حركة" لم تشهد مثيلها طيلة عقود طويلة من تاريخها، إذ بدأت تشهد بدايةً تفكك النظم السلطوية بفعل انتفاضات شعبية كانت بدايتها في تونس ومصر، وانتقلت بعد ذلك إلى العديد من الدول العربية. جاءت هذه "الانتفاضات" نتيجة تراكم سنوات من التسلط والظلم كان عمادها الشباب. لكن، وعلى الرغم من التفاؤل بهذا "الحراك" العربي، ونجاح بعض "الحركات" في إسقاط السلطة الحاكمة، إلا أنها ولّدت صراعات جديدة، وفشلت في معظمها، في معالجة المظالم الاقتصادية والاجتماعية التي انتفضت الجماهير من أجلها. وإذ يُسجل أن معظم هذه الحركات جاءت عفوية، إلا أنه بدا كأن أيديًا خفية كانت تخطط لها، وتهيء الأرضية لنجاحها، ومن ثم استغلال نتائجها.
- الكلمات المفتاحية: الثورة، الاحتجاجات، الأنظمة السلطوية، الديمقراطية، الربيع العربي، الولايات المتحدة، لعبة الدومينو، القوة الناعمة، الدبلوماسية الرقمية
***- مقدمة
بعد عقود من الانحطاط، ومن دون سابق إنذار، اجتاحت العديد من بلدان المنطقة العربية احتجاجات وثورات، عرفت باسم ثورات "الربيع العربي" وكان ذلك في العام 2011. هذه الاحتجاجات السلمية كانت صرخة قوية تعبر عن مدى المعاناة التي تعيشها شعوب المنطقة ضد الظلم والتهميش والفساد السياسي والبطالة التي يعيشها الشباب العربي. وعلى الرغم من اختلاف السياسات المحلية لكل بلد، فإن هذه "الثورات" تقاطعت في عدد من المطالب التي رفعت مثل: العدالة والحرية والديمقراطية وإنهاء الفساد وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية التي يعيشها المجتمع.كان من نتائج هذه "الانتفاضات الشعبية" أن أسقطت عروشًا وهزّت أنظمة أخرى، وفرضت واقعًا جديدًا على المستوى السياسي والاجتماعي لم تكن لتخطر على بال أكثر المراقبين حنكة في أواخر العام 2010.التساؤلات التي تطرح هي حول وصف هذا "الحراك" وماهيته، وما هي أسبابه، ومن المستفيد منه؟ أو ما هي محركات التغيير والأسباب السياسية والاقتصادية التي دفعت به بعد عقود طويلة من السكون والركود؟ ولماذا ثارت هذه الشعوب الآن ومن وراءها؟ وهل هذا الحراك يعبر عن صوت الناس وألمهم أم هناك من استغل هذا الألم وجيره لمصالحه؟ هل نجح الحراك في تحقيق غاياته؟
- محركات التغيير التي أدت إلى "الثورة"
إن "الثورة" عملية تغيير سريع وجذري للنظام السياسي مما يؤدي إلى الإطاحة بالنظام القديم والنخبة التابعة له، وإحلال نظام جديد تتوافق عليه مختلف أطياف المجتمع. أما البحث عن مسببات "الانتفاضة" أو "الثورة" أو ما اصطلح على تسميته بـ"الربيع العربي"، إنما تعود جذوره إلى المرحلة السابقة عليها، لأن هذه المرحلة هي التي أدت إلى هذا الواقع الذي تعيشه الشعوب العربية، وهو نتاج متراكم لسنوات عديدة من الاستبداد والظلم والاحباط وصولًا حتى العام 2011. فهناك عدد من العوامل التي حددت الواقع العربي في الفترة الماضية، أدت إلى تكريس واقع التجزئة والتخلف والاستبداد حتى حرمت الشعوب العربية من بناء الدولة المدنية الديمقراطية([i]). ويمكن إيجازها بستة عوامل:(...)***
* باحثة من لبنان. أستاذة مساعدة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية (قسم التاريخ) - الجامعة اللبنانية
([i]) الحوار المتمدن، مقالة لعبد الغني سلامة: عصر الثورات العربي الأسباب والتداعيات، ع 3332- 10/4/2011. Https://www.ahewar.org
الحداثة (Al Hadatha) – س. 29 – ع. 223 - ربيع 2022 SpringISSN: 2790 -1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on May 17, 2022 10:04
الشعرية في أغنية الأخوين رحباني ("سَوا رْبِيْنَا" أنموذجًا)
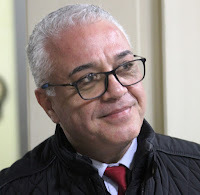
♦ مطانيوس قيصر ناعسي *
- نبذة عن البحث

يعالج هذا البحث الشِّعريَّة في أغنية الأخوين رحباني،[1] ولا سيّما في أغنية "سَوا رْبِيْنَا" التي غنّتها السيّدة "فيروز" في العام 1969،[2] طارحًا إشكالية كيف تبدَّت الشِّعريَّة ومستوياتها التي احتواها هذا النصّ، مُحَقِّقَةً أدبيّته، وديمومته، وبقاءه؟ فالشِّعريَّة تسعى إلى كشف مكنونات النّصّ الأدبيّ وكيفيّة تحقيق وظيفتيه الاتّصاليّة والجماليّة، وهي تعني بشكل عامّ قوانين الإبداع الفنِّيّ. وهذه اللفظة تُعَدُّ مُقابلًا مُناسبًا لمـُصطلح "Poétics"[3]، وقد تمحورت اشتغالاتها منذ القديم، وإلى الآن، في استقصاء القوانين التي استطاع المـُبدع التّحكّم بوساطتها في إنتاج نصِّه، والسّيطرة على إبراز هويّته الجماليّة، ومنحه الفرادة الأدبيّة.إنَّ أوّل من استخدم مصطلح الشِّعريّة "Poétics" هو "أرسطو Aristotle "[iv] في كتابه "فن الشعر"، ولم يجر تداول هذا المصطلح في النّقد العربيّ إلّا بعد مروره بمراحل ثلاث:1- مرحلة التّقبّل: وفيها جرى تعريب المصطلح إلى "بويطيقا".2- مرحلة التّفجّر: وجرت ترجمته إلى "فنّ الشِّعر".3- مرحلة الصّياغة الكلِّيَّة: وجرى تداوله كما هو الآن "الشِّعريَّة".إنَّ لمصطلح "Poétics" مقابلات تنوّعت واحتشدت فصار هناك: "الشِّعريَّة، والإنشائيَّة، والشّاعريَّة، والأدبيَّة، وعلم الأدب، والفنّ الإبداعيّ، وفنّ النَّظم، ونظريَّة الشِّعر، وبويطيقا، وبويتيك...إنَّ هذه المسمّيات العديدة لحقل معرفيّ واحد، تلتقي في جوانب معيَّنة وتفترق في أخرى، وهذا ما دعا إلى ضرورة توحيدها في مصطلح واحد "الشِّعريَّة". وهي دراسة منهجيّة تقوم على علم اللغة للأنظمة في النّصوص الأدبيّة، وهدفها دراسة أدبيّة تلك النّصوص، فهي إذًا شعريّة نصِّيَّة لا تُحيلُ القارئَ إلّا إلى النَّصِّ نَفْسِه.
- ما هو موضوع الشِّعريَّة؟
إنَّ أوَّل من تصدَّى للجواب عن هذا السّؤال هو تزفيتان تودوروف (Tzvetan Todorov)[v] الّذي تتحدَّد "الشِّعريَّة" عنده من خلال كامل نتاجه النَّقديّ التّنظيريّ والتَّطبيقيّ[vi]. يقول: إنَّها تشمل الشِّعر والنَّثر، وإنَّ العمل الأدبيّ في حدِّ ذاته ليس موضوعها، فما تستنطقه هو خصائص هذا الخطاب النّوعيّ الذي هو الخطاب الأدبيّ... وهذا العلم لا يُعنى بالأدب الحقيقيّ بل بالأدب الممكن، بعبارة أُخرى، يُعنى بالخصائص المـُجرَّدة الّتي تصنع فرادة الحدث الأدبيّ، أي الأدبيَّة.[vii]
ومِنَ الّذين توسّعوا في مفهوم الشِّعريَّة أيضًا:
1- جان كوهن (Jean Cohen)[viii] الذي بنى شعريّته على "الانزياح"، وتتمحور نظريّته حول الفرق بين الشِّعر والنّثر من خلال الشّكل وليس المادّة... ليلتقي بذلك مع "أدونيس"[ix] الّذي يقول: "يُبالغ بعضهم فيرى أنَّ مُجرّد الكتابة بالوزن تقليدٌ وِقِدَم، ومُجرَّد الكتابة بالنَّثر تجديد وحداثة. وهذا القول هو الوجه المـُقابل للقول التَّقليديّ إنَّ الوزن هو، وحده، الشِّعر، والنَّثر، أيًّا كان، نقيض للشِّعر. إنَّ هؤلاء لا يؤكِّدون على جسد الشِّعر، وإنَّما يؤكِّدون على لباسه الخارجيّ: لا يُعنون بمادَّة الشِّعر، بل بشكله الوزنيّ، أو النَّثريّ...".[x] والشِّعريَّة عند كوهن تعالج شكلًا من أشكال اللغة، أمّا اللسانيّات فتعنى بالقضايا اللغويَّة بعامّة... وهو يُعرِّف الشِّعريَّة بوصفها "علم الأسلوب الشِّعريِّ، أو الأسلوبيّ".[xi]
2- مايكل ريفاتير (Michael Riffaterre)[xii]: الانزياح عنده يُعدّ خروجًا عن النّمط التّعبيريّ المتواضَع عليه، وهو خروج عن القواعد اللغويّة وعن المعيار الذي هو الكلام الجاري على ألسنة النّاس في استعماله وغايته...
3- جوناثان كلر (Jonathan Killer)[xiii]: الشِّعريّة هي في الأساس نظريّة في القراءة، تبتكر أسئلتها عن الـ"كيف" مع الـ"ماذا" بتوازن يكفل أحدهما الآخر ويعاضده...
4- كمال أبو ديب [xiv]: الشِّعريّة عنده ليست مُختصَّة في الأشياء ذاتها، بل في تموضع الأشياء في فضاء من العلاقات أوّلًا، تنمو بين مُكوِّنات أوَّليَّة، ليتحوّل كلّ منها في السِّياق الّذي تنشأ فيه إلى فاعليَّة خلقٍ للشِّعريَّة، ومؤشِّر على وجودها.[xv]
- قصيدة "سَوا رْبِيْنا"
بناءً على كلّ ما تقدّم، يُمكن الانطلاق في دراسة الشِّعريَّة ضمن قصيدة "سَوا رْبِيْنا" لـ"الأخوين رحباني"، التي غنّتها السيّدة "فيروز"، فتلقّاها النّاس خير تلقٍّ لكون "مجال الشِّعر هو الشّعور"[xvi]، وأولى مميِّزاته استثمار خصائص اللغة[xvii]، ولكون "الأدب العظيم هو، بكلِّ بساطة، لغة مشحونة بالمعنى إلى أقصى درجة ممكنة"[xviii]. تقول القصيدة:
سَوا رْبِيْنَا
سَــوا رْبِيْنا سَــوا مْشِيْنَاسَــــوا قَضَّيْنــَــا لَيــالِيْنـَــامَعْقـول الفْـرَاق يِمْحي أَسامِيْنَاوْنِحْنا سَـوا سَــوا رْبِيْنــَـا؟
***
إِنتِ وأنــَـا دِرْنـَـا عَ كِلّ البْـوابحَبَّيْنا وكْبِرْنــَــا بِمَوْسِم العِنّـابوِنْطَرْنــَـا الجَنَى بِليالي الجَنَىوقْطَفْنــَــا الفَرَح من عَلاليْنَـا
***
قَوْلِك بَعد الرِّفْقَه والعُمْـر العَتيـقمْنُوقَع مِتِل وَرْقَه كِلْ ميْن عَ طريقوْيِنْسانا السَّهر بِلَيْـل السَّهـرويِسْألـو عَنَّـا أهـــاليْنــَـا
(كلمات وألحان: الأخوان رحباني)(...) ***
* كاتب وباحث لبناني - يعد أطروحة دكتوراه في اللغة العربية وآدابها في المعهد العالي للدكتوراه – الجامعة اللبنانية
[1] الأخوان رحباني: شاعران وموسيقيَّان لبنانيَّان، هما: عاصي الرّحباني (1923- 1986) ومنصور الرّحباني (1925- 2009)، تركا إرثًا شعريًّا وإرثًا موسيقيًّا كبيرين، اشتهرا بمسرحهما الغنائيّ، من أبرز أعمالهما: مسرحيَّة الشَّخص (1969م.) الّتي تضمَّنت أُغنية "سوا ربينا".[2] فيروز: مُطربة وممثّلة لبنانيَّة، (1935- ...)، اسمها الأصليّ "نُهاد وديع حدَّاد"، تُعَدُّ أيقونة في الفنّ الغنائيّ اللبنانيّ، من أبرز أعمالها: أغنية سَوا رْبِيْنَا.[3] حسن ناظم، مفاهيم الشِّعريَّة دراسة مُقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم، المركز الثَّقافيّ العربيّ، بيروت، ط.1، 1994، ص. 17[iv] أرسطو: فيلسوف يونانيّ، (384 -322 ق. م.)، هو تلميذ أفلاطون ومُعلِّم الإسكندر الأكبر، ومن كبار المـُفكِّرين، من أبرز أعماله: "فنّ الشِّعر".[v] تزفيتان تودوروف: فيلسوف فرنسيّ- بلغاريّ، (1939م.- 2017م.)، كتب حول الأدب وتاريخ الفكر والثَّقافة، حاضر في جامعات عديدة، من أبرز أعماله: "شعريَّة النَّثر".[vi] بشير تاوريريت، الشِّعريَّة والحداثة بين أفق النَّقد الأدبيّ وأفق النَّظريَّة الشِّعريَّة، دار رسلان للطّباعة والنَّشر والتَّوزيع، دمشق، ط.1، 2008م.، ص. 34[vii] تزفيتان تودوروف، الشِّعريَّة، ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال للنَّشر، الدَّار البيضاء، ط.1، 1987، ص. 2[viii] جان كوهن: فيلسوف فرنسيّ وأستاذ في جامعة السّوربون، (1919م.-1994م.)، من أبرز أعماله: بنية اللغة الشِّعريَّة.[ix] أدونيس: شاعر وناقد سوري- لبناني (1930-...)، اسمه الحقيقيّ "علي أحمد سعيد إسبر"، أستاذ في كلِّيَّة التَّربية- الجامعة اللبنانيَّة (1971-1985)، قاد ثورة حداثيَّة، من أبرز أعماله النَّقديَّة: الشِّعريَّة العربيَّة[x] أدونيس، الشِّعريَّة العربيَّة، دار الآداب، بيروت، لبنان، ط.1، 1985، ص. 94[xi] الشِّعريَّة والحداثة بين أفق النَّقد الأدبيّ وأفق النَّظريَّة الشِّعريَّة، ص. 50[xii] مايكل ريفاتير: ناقد فرنسيّ، (1924- 2006)، درَّس في جامعة كولومبيا، من أبرز أعماله: سيميائيَّة الشِّعر.[xiii] جوناثان كلر: ناقد أمريكيّ، (1944م.-...)، أستاذ في جامعة كورنيل، من أبرز أعماله: الأدب والنَّظريَّة الأدبيَّة.[xiv] كمال أبو ديب: كاتب وناقد سوريّ، (1942م.-...)، ترجم العديد مِنَ الكُتُبِ إلى العربيَّة، من أبرز أعماله: جدليَّة الخفاء والتَّجَلِّي[xv]كمال أبو ديب، في الشِّعريَّة، مطبعة الأبحاث العربيَّة، لبنان، لا ط.، لا ت.، ص. 14[xvi] محمّد غنيمي هلال، النَّقد الأدبيّ الحديث، دار العودة، بيروت، ط.1، 1982، ص. 376[xvii]مهى الخوري نصّار، البنية الأسلوبيَّة، دار سائر المشرق، بيروت، ط.1، 2016، ص. 13[xviii] Ezra, Pound: A.B.C. de la lecture, Gallimard, Paris, 1967, p.22-30
الحداثة (Al Hadatha) – س. 29 – ع. 223 - ربيع 2022 SpringISSN: 2790 -1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on May 17, 2022 09:44
مستويات التأشير ووظائفه من خلال كتاب خالد لأمين الريحاني



♦ زينة محمود سعيفان*
- نبذة عن البحث
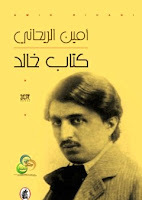
تسعى هذه الورقة العلميّة إلى وضع إطار منهجيّ يدمج السرديّة التي تُعنى بدراسة الرواية، بالألسنيّة التي تعنى بدراسة لغة النصّ ومكوّناته التلفّظية. وينطلق هذا الإطار المنهجي الجديد، من افتراض مفاده أنّ هيمنة الوظيفة السرديّة على الوظيفة المرجعيّة للغة لا تخفي عن الباحث ملامح الإحالة الزمنية الدقيقة، إنّما تجعلها غامضة. لذا فمن المفيد دراسة "التأشير"Deixis) ) في إطاره السردي لكونه يوظف عناصر السرد في خدمة كشف الزمان.....ويعالج البحث المؤشّرات التلفّظية اللغويّة الدالّة على الزمان ضمن إطار سردّية الناقد الفرنسيّ جيرار جينيت (Gérard Genette/ 1930 – 2018)، بما يمكّن الباحث من تتبّع آثار الزمن وقياسها في الرواية بمنظور جديد، وبمقاربة دامجة، وبمرجعيّة إحاليّة واضحة، بحيث يتمّ توظيف المعطيات الداخليّة التي يقدّمها لنا الملفوظ، للكشف عن تكوّن خطاب السرد وتحديد استراتيجيّاته.ولتوضيح العلاقة التي تربط الزمن بالسرد الروائي لا بدّ من تحديد المكوّنات الزمنيّة التأشيريّة التي تبديها ملفوظات الحكائيّة، ودراسة آليّات تشكّلات تقنيات الزمن في رواية محدّدة، وقد اخترنا في هذا البحث تطبيقيًّا رواية "كتاب خالد" للكاتب اللبناني أمين الريحاني (1876 – 1940) الصادرة في طبعتها الأولى باللغة الإنكليزية في نيويورك 1911، مستشهدين بشواهد قصيرة لعدم الإطالة، ومحيلين إلى النصّ الأصلي حيث يطول الشاهد، مستخلصين المؤشّرات الدالة على الترتيب الزمنيّ والسرعة السردية وعلاقات التواتر، لنخلص إلى كيفيّة تجسيد الإطار السرديّ لفكر المؤلف في الموت ونظرته إلى الخلاص.- الكلمات المفاتيح: الرواية اللبنانيّة - تأشير – سرديّة - مؤشّرات – زمان – مرجعيّة – أمين الريحاني***- Résumé: Cet article propose développer un nouveau cadre méthodologique qui intègre la narrativité intéressée au roman, à la linguistique, intéressée à l'étude des éléments linguistiques textuels.Cette approche met en relief les Déictiques, comme traits de la référence temporelle, et examine leurs fonctions dans le cadre narratif de Gérard Genette.Dans cette perspective, il est nécessaire de définir les composantes temporelles dans une étude appliquée.Le corpus choisi est le roman intitulé “Le livre de Khalid” pour son écrivain libanais Amin al Rihani, pour examiner comment le cadre narratif incarne la pensée de l'auteur sur la mort et sa vision du salut.- Mots-clés: Le roman libanais - Deixis - Déictiques – Temps - Référence- Narrativité - Amin al Rihani***- المُقَدِّمةيتطلّب إدراك الزمن في السرد مجموعة من الوسائل والأدوات التي تجتمع في مقاربة واحدة أو أكثر كي يتمكّن الباحث من تتبّع آثار الزمن وقياسها في الرواية. ويعدّ التأشير (Deixis) ببعديه الزماني والمكاني أحد أبرز عناصر التلفّظ في النصّ الروائيّ، وتُعنى دراسته بوصف العلاقات الموجودة بين المعطيات الداخليّة التي يقدّمها لنا الملفوظ، والتي تكوّن خطاب السرد وتحّدد استراتيجيّاته.في هذا الإطار تمثّل جهود جيرار جينيت (Gérard Genette) التيّار النقديّ الطامح إلى توضيح فعل الكتابة ذاته من خلال "إقامة نظريّة عامّة في الأشكال الأدبيّة تستكشف إمكانات الخطاب"[i]. ويؤكّد جينيت منهجه البنيويّ الداخليّ "الهادف إلى البحث في مقوّمات النصّ الداخليّة، بعيدًا من الإكراهات الخارجيّة مهما كانت اجتماعيّة أو تاريخيّة، حين يقول: "إّن اللوم الموجّه للنقد الجديد -الموضوعاتيّ والشكلانيّ- بأنّه يهمل ولا يبالي بالتاريخ، مردود، لأنّنا نضع التاريخ بين قوسين ونؤجّله لأسباب منهجيّة. والنقد الشكلانيّ غايته البحث في نظرية الأشكال الأدبيّة، أو بشكل مختصر يبحث في الشعرية"[ii]. وعليه فقد وجّه جينيت بحثه نحو الإشكاليّات النقديّة الكبرى؛ كحدود السرد، والأشكال الأدبيّة السرديّة، وأشكال النصّ الأدبيّ وشبكة دلالاته ورموزه ليتتبّعها، ويضيء على خصائص السرد. ولتوضيح العلاقة التي تربط الزمن بالسرد الروائي لا بدّ من تحديد المكوّنات الزمنيّة التأشيريّة التي تبديها ملفوظات الحكائيّة، ودراسة آليّات تشكّل تقنيات الزمن في الرواية، وتُعنى الدراسة في النظر إلى التأشير وإلى جهود جينيت من خلال:- تحرّي إيقاع الزمن عبر تقنيّات الحذف والتلخيص وكلّ ما يعين في الإسراع وتخطّي اللحظات الحكائيّ؛- تحرّي اتّجاه الزمن أي تناول النسق الزمني المتصاعد؛- تحرّي إحساس الشخصيّة بالزمن أي بنائها داخل السرد.ويتمّ ذلك من خلال دراسة عناصر التأشير داخل السرد، فـ"التأشير" يُفهم منه تعيين مكان الأشخاص وهويّاتهم، كذلك الأشياء والأحداث. ويكون التحديد نسبةً إلى السياق المكانيّ- الزمانيّ الذي أنشأه التلفّظ. وتُقسم الإشاريّة (Déictique) غالبًا - حسب الميادين الثلاثة المكوّنة لمقام التلفّظ - إلى إشاريّة شخصيّة، ومكانيّة، وزمانيّة، لكنّ بعضهم يخصّص مفهوم الإشاريّة للعلاقات المكانيّة - الزمانيّة. أمّا التأشير الشخصيّ (Person Deixis) فهو كما يعرّفه اللغوي الأميركي جورج يول (George Yule )- صيغ تُعتمد للإشارة إلى أشخاص مثل "أنا" و"أنتم".[iii]وإذا كان التأشير ظاهرة فالإشاريّات هي عناصر هذه الظاهرة. وهي في الوقت ذاته رموز وعلامات تنتمي إلى وضع اللغة من جهة، وتحتوي على عناصر من السياق من جهة أخرى، فالضمير "أنا" يشير إلى الشخص المتكلّم في إطار وزمن محدّدين. والإشاريّات عناصر لغويّة لا تدلّ على شيء بعينه بقدر ما تنوب عنه، وتُترجَم بالمبهمات أحيانًا، وذلك لكونها "لا تشير إلى شيء ثابت في العالم، ولا إلى أوضاع موضوعيّة في المكان والزمان، إنّما لأنّها تحيل دائمًا إلى حالة الخطاب الذي ترد فيه". إلاّ أنّنا نبقي على مصطلح الإشاريّات اشتقاقًا من المصدر تأشير[iv].وتنبغي الإشارة إلى أنّ دراسة التأشير تأتي ضمن المقاربة التداوليّة المعرفيّة التي طرحتها الفرنسية آن روبول (Anne Reboul) في الكثير من مؤلفّاتها ومقالاتها. وقد انفتح الكثير من السرديّين البنيويّين على هذه المقاربة الجديدة، كما استفادت هي ذاتها ممّا حقّقه البريطانيّان أوستن (John Austin) وغرايس (Paul Grice)، والأميركي سيرل (John Searle)، ومن نظريّة الملاءمة كما قدّمها الفرنسي سبربر (Dan Sperber) والبريطانية ولسن (Deirder Wilson)[v].ويُعدّ الفرنسي بنفنسيت (Émile Benveniste) أشهر من نظّر لها، إذ أكّد ضرورة التمييز بين اللغة كسجلّ من الأدلّة ونظام تتركّب فيه هذه الأدلة، واللغة كنشاط يتحقّق من خلال وقائع الخطاب التي تخصّصها علامات خاّصة، تلك العلامات التي يسمّيها بنفنيست "المؤشّرات"، يكمن دورها في تحويل اللغة إلى خطاب فعليّ.هذا التعبير يسمّيه التلفّظ وهو عمليّة إنتاج الملفوظ أي مجموعة العوامل والأفعال التي تسهّل إنتاجه، وهو بالتالي إجراء اللغة وتحقيقها من خلال فعل كلام فرديّ.ينصبّ الجهد في هذا البحث على تسليط الضوء على الإشاريّات الزمنيّة المدمجة في السرد والمدروسة من خلال نظرية جينيت، بهدف دراسة مسألتي الموت والخلاص دراسة سرديّة مدمجة بالدراسة المرجعيّة الإحالية من خلال تتبع عناصر التلفّظ المرتبطة بالزمان ومرجعيّاته في النص. فالموتُ حدثٌ من أحداثِ الحياة لا يمكن الهروب منه، وهو مجال تأمّلٍ وبحث، فإذا كانت حياة الإنسان على الأرض، أو ضمن حدود الزّمان والمكان، تتأثّر بمقاربته مفهوم الموت وبحثه عن الخلاص، أو انتفاء ذلك البحث، فإنّ مفهوم الإنسان للموت وما بعده يُحدِّد مفهومه للزّمان.فالزّمان في لسان العرب مرادف للزّمن، وهو اسم لقليل من الوقت وكثيره، وقد يعني أيضًا العصر[vi]. ويستعمل المعجم الفلسفي مفردة الزّمان بمعنى الوقت كثيره أو قليله؛ وهو المدّة الواقعة بين حادثتًيْن أوّلهما سابقة وثانيهما لاحقة[vii]. يُقال أيضًا، إنَّ الزّمان إذا جاء مرادفًا لمعنى الدّيمومة دلَّ على الوسط الذي تجري فيه الأفعال والحوادث، وإذا كان مختلفًا عنه دلَّ على الزّمان المطلق[viii]. وهناك أيضًا الزّمان الوجداني المصبوغ بالانفعال وهو ليس كمًّا ولا يقبل القياس[ix].وقد جاء تعريف الموت في المعجم الفلسفي على أنّه يخالف الحياة: "الموت عدم الحياة عمّا من شأنه أن يكون حيًّا، وقيل الموت: نهاية الحياة، وضدّ الحياة"[x]. وهناك فكرة الموت الصّوفي: "الحجاب عن أنوار المكاشفات والتّجلّي، وهو قمع هوى النّفس"[xi].من هنا قيل إنَّ الموت موتان: موت إراديّ وموت طبيعي، وبالتالي ثمّة ثلاثة مفاهيم للموت الطّبيعي ومصير النّفس ما بعد الموت. فمِن النّاس من يعتقد بالفناء، أي إنَّ الموت جدار تنتهي عنده الحياة؛ ومنهم من يؤمن بالقيامة، أي إنَّ ما بعد الموت حياة أبديّة؛ ومنهم من يؤمن بالتّناسخ أو بالتّقمّص، أي إنَّ الموت عبّارة للرّوح من حياة إلى حياة جديدة ضمن عالم المادّة.ومن المُلاحظ أنَّ المفهوم الأوّل لا يهتمّ لقضيّة خلاص الرّوح بعد الموت لأنّه لا يؤمن بالحياة بعد الموت. أمّا المفهومان الأخيران فمتعلِّقان مباشرة بمفهوم الخلاص لأنّهما مرتبطان بالحياة بعد الموت ويسعيان إلى تحقيق مصير أفضل للرّوح بعد الموت.لذا نحلّل بالتفصيل عناصر التلفّظ الأساسيّة من حيث التأشير والمرجعيّة، والـ"أنا" أي المتكلّم الذي يصدر عنه الخطاب؛ والـ"هُنا": المكان الذي ينتج فيه الخطاب؛ والـ"آن": الزمن الذي ينتج فيه الخطاب أو اللحظة التي تتمّ فيها عمليّة التواصل. وقد شكّلت العودة إلى المعجم اللغويّ الخاص بالخلاص تقنيّة إحاليّة معتمدة من قبل الكاتب لكونها من باب الإشارات المرجعيّة، وثيقة الصلة بالتأشير الزماني وفلسفة الكاتب بالنظر إلى موضوعي الموت والخلاص، والسياق المرتبط بهما بوصفه سياقًا وجوديًّا.وبما أنَّ العمل الرِّوائي هو عمل إنسانٍ في الزّمن، وهو في النِّهاية سردٌ لأحداث، والأحداث مرتبطة بالزّمن، فزمنيّة السّرد الرّوائي حتميّة، وهذا ما يؤكّده جنيت في قوله: "فزمنيّة السّرد شرطيّة؛ يُنتَج السّرد في الزّمن مثل أيّ أمرٍ آخر، ويوجد في المكان كمكان، والزّمن الواجب "لاستهلاكه"، هو نفسه الزّمن اللازم لعبوره واجتيازه، تمامًا كالطّريق أو الحقل. النّصّ السّردي، كأيِّ نصٍّ آخر، ليس له من زمنيّة أخرى سوى تلك التي يستعيرها، مجازيًّا، لقراءته الخاصّة"[xii].فالسّؤال المطروح أمام المفاهيم الثّلاثة للموت وأمام زمنيّة العمل الرِّوائي، هو التّالي: هل تساعد دراسة تقنيّة الزّمن ببعدها الإشاريّ المرجعيّ المدمج بمنهجيّة جيرار جينيت، على استخلاص مفهومَيْ الموت والخلاص عند الكاتب الرّوائي؟هذا السّؤال يفترض تحديد منهجيّة جينيت في دراسة الزّمن، ولا سيّما في كتابه "Figures III" الصادر في باريس في العام 1972،[xiii] وتطبيقها على رواية للوصول إلى مفهوم الموت والخلاص عند المؤلِّف. هذا يفترض أن يكون اختيار الرِّواية عشوائيًّا وأن تكون هويّة المؤلّف مجهولة بالنِّسبة إلى الباحث لكي لا يتأثّر تطبيق تقنيّة دراسة زمن السّرد على الرّواية، بالمعرفة المسبقة لمفهوم الموت والخلاص، وبالتّالي يكون العمل أكثر موضوعيّة وشفافيّة.فمنهجيّة جينيت مثلًا، تمّت من خلال دراسته لرواية البحث عن الزّمن الضّائع، للرّوائي الفرنسي مارسيل بروست (Marcel Proust). [xiv]وقد اتّبعنا منهجيّة ألسنيّة تطبيقيّة كما في دراسة عناصر التلفّظ، ركّزنا فيها على استخلاص المؤشّرات الزمانيّة وعلاقتها الإحاليّة المرجعية بمسألتي الموت والخلاص، مدمجين هذا التوجّه الألسني بمنهج جينيت في دراسة الزّمن الروائي.هذه المنهجيّة تتيح تمييز عناصر التأشير في زمن القصّة (أي التّتابع التّسلسلي والمنطقي لأحداثها)؛ عن تلك التي لزمن السرد (أي تتابع الأحداث بحسب ورودها في النّص الرِّوائي). وبالتّالي، تقوم على دراسة المفارقات الزّمنيّة بين القصّة والسّرد من خلال دراسة الرّجعات والاستباقات الزّمنيّة، كذلك دراسة سرعة زمن السّرد بالنّسبة إلى زمن القصّة من خلال دراسة تقنيّات الوقف الزّمني والمشاهد الحواريّة والحذف والتّلخيص الزّمنيّيْن.
- أقسام البحث
يقسّم البحث ثلاثة مباحث:
- الأوّل لتفصيل المؤشّرات بمنظور نظريّة جينيت
- الثّاني كان تحليليًّا تطبيقيًّا لدراسة الزّمن في رواية كتاب خالد
- وخلصنا في المبحث الثّالث إلى كيفيّة تجسيد الإطار السرديّ لفكر المؤلّف في الموت ونظرته إلى الخلاص من خلال الزمن وإشاريّاته في السرد.(...)***
* أستاذة مساعدة في اللغة العربيّة وآدابها (تخصّص: لسانيّات النصّ وتحليل الخطاب)، كلّيّة الآداب والعلوم الإنسانية - الجامعة اللبنانيّة؛ ومعهد الآداب الشرقيّة - جامعة القدّيس يوسف.
[i] عبد الجليل الأزدي (محمد معتصم): مقدمة ترجمة خطاب الحكاية، ص.25[ii] Gèrard Genette: Figure lll, p. 13[iii] معجم تحليل الخطاب، إشراف شارودو ومنغونو، ص 156؛ يول (جورج)، التداوليّة، ص. 194؛ بلخير (عمر)، معالم لدراسة تداوليّة وحجاجيّة للخطاب الصحافيّ الجزائريّ، ص. 103[iv] روبول (آنّ)، وموشلر (جاك)، التداوليّة اليوم، ص. 105[v] راجع كتابهما "الملاءمة: التواصل والمعرفة".[vi] ابن منظور (جمال الدّين)، لسان العرب، ص. 103[vii] صليبا (جميل)، المعجم الفلسفي، جزء 1، ص 636[viii] م.ن.، ص 639[ix] م.ن. ص 709[x] صليبا (جميل)، المعجم الفلسفي، ص.87[xi] م.ن.، ص. 102[xii] Gérard Genette, Figures III, p. 78.[xiii] Ibid. p. 79.[xiv] مارسيل بروست (Marcel Proust): روائي فرنسي عاش بين 1871 و1922، من أشهر أعماله "البحث عن الزّمن الضّائع" (A la recherche du temps perdu)، في سبعة أجزاء، نُشِرَت بين 1913 و1927
الحداثة (Al Hadatha) – س. 29 – ع. 223 - ربيع 2022 SpringISSN: 2790 -1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on May 17, 2022 09:29
•
Tags:
alhadatha, مجلة-الحداثة
May 14, 2022
ظاهرة الذكورة وتأثيرها في شعر نزار قباني (قراءة ثقافية في نماذج مختارة)


♦ إبراهيم صالح سعد *
نبذة عن البحث
تقترن "الذكورة" بكل ما يميز الرجل عن المرأة ويمنحه الأفضلية في الاكتساب والقدرة على المنع والضغط والتحكم بالآخر، ولا سيما المختلف وهو "الأنثى". وبالتالي ليس دقيقًا فحسب، اقتران الذكورة بوصفها سلطةً بالفرض على الآخر المختلف جنسيًّا (الأنثى)، أو حصرها بعنوان القدرة الجنسية وفعلها أو فاعليتها عند الرجل وتوكيدًا لها، يقال رجلٌ ذكر كما يقال تعبيرًا عن قوتها عنده أنه فحلٌ، هذه الفحولة لا يتردد في إظهار عنفوانها، ولا في الابتهال لاكتسابها، ولا في الاحتفال بها(1)،يعالج هذا البحث هذه الظاهرة (الذكورة) وتأثيرها في شعر الشاعر السوري نزار قباني (1923- 1998م) من خلال نماذج مختارة، فيسعى بدايًة إلى عرض بعض الآراء العربية في مفهوم الذكورة على المستوى العربي تحديدًا، ومن ثمّ يعالج البحث عبر قراءة ثقافية، الذكورة وتأثيرها في شعر قباني؛ فهل بدا مؤيدًا أم رافضًا لها، أم تضمن شعره الاتجاهين معًا؟
- في مفهوم الذكورة العربية
يرى الباحث الأكاديمي اللبناني د. وجيه فانوس (1948م)، أنَّ المجتمع العربي "مجتمع ذكوري بصورة عامة وشاملة، إلا أنَّ هذه الذكورية، كانت مؤسسةً ومنطلقةً إلى حدٍّ كبيرٍ في عيش وجودها، من خلال المرأة وبها ولها، لهذا فقد يمكن القول إنها إلى حدٍّ كبيرٍ ذكوريةٌ مؤسسةٌ على رداتِ فعلٍ موضوعها المرأة، فالمرأة، تمثل هاجسًا أساسًا في الحياة المجتمعية العربية، فهي موضوع جوهري في حياة الرجل، تمثل له الشرف، بقدرته على حمايتها وصونها ورعايتها، كما تمثل له الاستقرار، بركونه إليها والاستمرار بما تُنجِبُهُ من ذريِّة، وهي العار إذا ما ظهرت بخلاف ذلك، ولعل المساحة التي احتلتها المرأة في تشكيل نسيج حياة العرب المجتمعية أكثر اتساعًا من المساحة التي احتلها الرجل"(2)، لهذه الأسباب جميعًا، فقد سعى الرجل، عبر تاريخٍ طويلٍ، من التعايش مع المرأة إلى السيطرة عليها والتحكم بكيانها، ومصيرها في كل جوانب الحياة المختلفة، الجنسية، والاقتصادية، والفكرية، و"المبالغة المفرطة في المحافظة والتشدد في التعامل مع التشريعات، والمفاهيم والقيم سواءً أكانت هذه جميعها، دينية الطابع، أو دنيوية، فوجد قطاع كبير من النساء العربيات أنفسهن، أمام سلوكيات تَحجرُ ليس على كثيرٍ من سلوكياتهن المجتمعية وحسب، بل تسعى إلى حجرٍ حتى على مشاعرهن ومناهج تفكيرهن"(3).ويمنح المفكر السوري جورج طرابيشي (1939– 2016م)، ظاهرةَ الشعور بالتفوق الذكوري المتغلغلة في وجدان الرجل الشرقي عمومًا وبشكلٍ أدقَ المثقف الشرقي المغترب في أوروبا، في منتصف القرن العشرين، أو قبل ذلك بقليل، بعدًا ثقافيًّا جنسيًّا في الوقت ذاته، وذلك في دراسة طرابيشي للأدب الروائي العربي، وكيفية تناوله العلاقة الحضارية بين الشرق والغرب، فهو يرى أن عملية المثاقفة بين الشرق والغرب مبنيةٌ أساسًا على وجود طرفين: موجب وسالب، فاعل ومنفعل، ملقِح وملقَح، ويرى أيضًا أن الثقافة الحديثة، كذلك القديمة، هي في الأساس والجوهر ثقافة ذكورية، ويزعم طرابيشي، أن المثقف الشرقي هناك، كان يشعر بالخصاء الفكري، والعُنة الثقافية، أمام الآخر بحسبانه فاعلًا في عملية المثاقفة هذه، إلا أنه لم يكن يشعر بالدونية المؤنثة، وهو نتيجة هذا الشعور، فإنه يلوذ بماضيه الحضاري الذي يفترض أنه ينُّمُ هو الآخرُ عن رجولةٍ، فحاولَ استعادة رجولته، في نظر الطرف الآخر بوصفها علاقةَ تحدٍ وسيطرة وعنف، أي إن هذا المثقف بدأ يقيم علاقة توازٍ وتماهٍ بين الثقافة والرجولة، فما دامت الثقافة رجولةً، فإن الرجولةَ ثقافةٌ أيضًا، أو بالأحرى ذكورة (4).ويرى طرابيشي أنَّ إحساس المثقف الشرقي بخصائه في الغرب، "لن يزيده إلا تشبثًا بذكورته، ومعاناته من العنة الفكرية لن تزيده إلّا تأجج فحولة، فإن لم يكن رجلًا في مضمار الثقافة، فليكن رجلًا وأكثر من رجل في مضمار الرجولة الطبيعي، وهذا معناه بصريح العبارة، أنَّ ردّ فعلهِ على عملية المثاقفة، ستكونُ بقضيبهِ، معه سيحملَهُ مُنتعِظًا مُعربدًا أينما حلّ وارتحل، وعلى الأخص في الأماكن التي تثور فيها الشكوك حول رجولته، أي في أماكن الثقافة؛ في مدرجات الجامعة؛ في دور السينما؛ في صالات المعارض وقاعات الموسيقى، لن يرى وهو في محراب هيكل الثقافة إلا المرأة، ولن يُصخ سمعًا إلا لموسيقى ساقيها"(5).على الرغم من أننا لا نميل إلى تبني وجهة نظر طرابيشي في ما يخصّ الخصاء الفكري والعنة الثقافية التي يفترض أن المثقف الشرقي العربي يعاني من تبعاتهما، إلا إنَّ هذا التحليل يمكن أن يقدم تصورًا دقيقًا عن تغلغل النسق الذكوري بمعناه الأيروسي الجنسي المضمر في كوامن لاوعي الرجل الشرقي الذي يحاول إثبات رجولته في الغرب، من خلال جسد المرأة، نتيجة الكبت الذي كان يعانيه في الشرق بحكم العادات والتقاليد الصارمة التي تحدد علاقة الرجل بالمرأة ضمن إطار الزواج فحسب، وهو تصور مغاير لما يقدمه وجيه فانوس الذي عالج وضع المرأة في المجتمع العربي ضمن الرقعة الجغرافية العربية على أنها تمثل شرف الرجل وعرضه، وصيانتها والدفاع عنها من أولوياته؛ وذلك بحكم العادات والتقاليد التي تحررت منها أكثر المجتمعات الغربية.
- نظرتان في شعر قباني
يطرح نزار قباني في شعره مظاهر الذكورة وهيمنتها وتسلطها على الآخر- المرأة بكيفياتٍ مختلفةٍ، وصورٍ متعددةٍ، ونماذج بعضها مأخوذٌ من الواقع، وبعضها الآخر مبتكر يستجيب لدواعي الرغبة، أو يكون مقترنًا بالعاطفة، أو موجهًا بالعقل لتدارك المخاطر التي ينطوي عليها الرضوخ المطلق لهذه السلطة من قبل المرأة، وطلبًا لإصلاح مناخ العلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمع من خلال معالجة حالات تتسم بالسلبية، وتصلح أن تكون عيناتٍ تغطي مساحاتٍ كبيرةً من واقع علاقة الرجل بالمرأة في المجتمع العربي، وهنا يجب دراسة هذه المظاهر بصوتي الرجل والمرأة، تكريسًا وتأييدًا، أو رفضًا وإدانةً، لمظاهر هذه السلطة وتنوعاتها، وإضافة سلطة العادات والتقاليد والشرائع إليها بحسبانها نتاجًا ذكوريًّا في الغالب، أو محميةً من المجتمع الذكوري، كما أنَّ "الرجولة بحسبانها ماهية القوة والفضيلة، ومناط الشرف ومبدأ حفظ الشرف والدفع إليه، تبقى على الأقل ضمنيًّا غير منفصلة عن الرجولة الجسدية، ولا سيما عبر دلائل القوة الجنسية ووظائفها المنتظرة من الرجل"(6)، وعلى الرغم من أنها تنصرف إلى دلالاتٍ أخرى كالفضيلة والشجاعة والمروءة وما إلى ذلك مما أسبغته عليها المنظومة القيمية للمجتمعات في الغالب، إلا أنَّ أمثلةً كثيرةً تحددها في القدرة الجنسية والذكورة وممارساتها بحسبانها سلطة مهيمنة على الجنس الآخر (المرأة) وموجهة نحوها، بما تتضمنه من تفوق.تلحظ في شعر قباني هذه السلطة وهيمنتها – بصوت الرجل- بصورٍ عديدةٍ ومتنوعةٍ ونماذجَ تشكلُ في مجملها التنوعَ الإنسانيَ في المواقف والرغبات المختلفة، وينظر الشاعر إلى هذه السلطة نظرتين مختلفتين؛ تتضمن الأولى تكريس الذكورة وإبراز عنفوانها، في حين تتناول الثانية إدانتها، والحط من قيمتها، والكشف عن ضعف إنسانيتها أو تحللها الأخلاقي، ولإيضاح هاتين النظرتين المتضادتين نعالجها من خلال نصوص الشاعر في هاتين النقطتين:(...)***
* باحث عراقي. يعدّ أطروحة دكتوراه في اللغة العربية وآدابها – المعهد العالي للدكتوراه – الجامعة اللبنانية
1- الطاهر لبيب: سيوسيولوجيا الغزل العربي، الشعر العذري نموذجًا، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط1، 2009، ص2342- وجيه فانوس: إشارات من التثاقف بالعربي مع التغريب في القرن العشرين، مطبعة فانوبرس، بيروت 2004، ص703- م. ن.، ص70-714- جورج طرابيشي: شرق غرب، رجولة أنوثة، دراسة في أزمة الجنس والحضارة في الرواية العربية، دار الطليعة، بيروت، ط4، 1997، ص11-135- م. ن.، ص146- بورديو، بيار: الهيمنة الذكورية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2009، ص307- نزار قباني: الأعمال الشعرية الكاملة، منشورات نزار قباني، بيروت مج1، ط 14، 1998، ص778- خريستو نجم: النرجسية في أدب نزار قباني، دار الرائد العربي، بيروت 1983، ص162
الحداثة (Al Hadatha) – س. 29 – ع. 223 - ربيع 2022 SpringISSN: 2790 -1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on May 14, 2022 07:01
•
Tags:
alhadatha, مجلة-الحداثة
الصدق والكذب عند العرب واللبنانيين من خلال أمثالهم (دراسة حضاريّة مقارنة)

♦ فارس ديب حنّا *
- نبذة عن البحث
يُعرّف هذا البحث الصدق والكذب، استنادًا إلى معاجم المصطلحات، ثمّ يُبيّن نظرة كلّ من العرب واللبنانيين إلى هذين المفهومين الأخلاقيّين المتناقضين، بالاستناد إلى كثرة من أمثالهم، حارصًا على تخريج كلّ مثل من مصادر الأمثال العربيّة واللبنانيّة الكثيرة، مشيرًا إلى ما ضرب به العرب المثل في كلّ من الصدق والكذب، مستخلصًا أنه لا تناقض بين أمثال العرب وأمثال اللبنانيين فيهما، بل تكامل وتوافق.
- الكلمات المفاتيح: الصدق، الكذب، المثل، الفضيلة، الرذيلة***1- تعريف الصّدق:
قال أبو البقاء الكفويّ (1094ه/ 1683م): "الصّدق إخبار عن المخْبَر به على ما عليه، مع العلم بأنّه كذلك"([i])، أو "هو أن يكون الحكم لشيء على شيء إثباتًا أو نفيًّا مطابقًا لما في نفس الأمر"([ii]).
2- الصِّدق في الأمثال العربيّة:
مدَح العربُ الصّدق، ودعوا، في أمثالهم إلى الالتزام به، قالوا: "سُبَّني واصْدُق"([iii])، أي: لا أبالي أن تسبَّني وتكون صادقًا. ووصفوا الصدق بأنّه:- عِزّ، قالوا: "الصّدْق عِزّ، والكذب خضوع"([iv]).- مَنْجاة. قالوا: "الصّدق منجاة"([v])، و"الصِّدق يُنجي، والكذب يُشجي"([vi])، و"مَنْ صدَقَ الله نجا"([vii])، و"إنْ كذِبٌ نَجّى، فصِدقٌ أخْلَق"([viii]).- شفاء. قالوا: "الكذب داء، والصِّدْق شِفاء"([ix])، وذلك أنّ الصادق يعمل على تقديرٍ يكون فيه مُصيبًا، والكذّاب يعمل ضدّ ذلك.- في مرتبة سامية بين المهابة والمحبّة. قالوا: "الصّدق بين المهابة والمحبّة"([x]).- الناطق عن حقيقة أمر الإنسان لا الوعيد. قالوا: "الصِّدْق (أو صدقك) ينبئ عنك لا الوعيد"([xi])، أي: إنّما يُنبئ عدوَّك عنك أن تصدقه في المحاربة وغيرها، لا أن تهدِّده دون تنفيذ تهديدك.وقالوا في تصديق الرجل صاحبه عند إخباره إيّاه: "صدَقَني (أو صدَقَك) سِنُّ بَكْرِه"([xii])، و"صَدَقَك (أو صدَقَني) وسْمَ قِدْحه"([xiii])، و"صَدَقَني قُحاح (أو قُحّ) أمره"([xiv])، أي: صدقني صِحَّة أمره وخالصه.وبحسبان الصدق عند العرب عزًّا، ومنجاة، وشفاء، وفي مرتبة سامية بين المهابة والمحبّة، فإنّ الصادق، عندهم، عزيز الجانب، ومهيب، ومحبوب، وفي مأمن المخاطر والأمراض، وهو، بالإضافة إلى ذلك، قويّ الحجّة صادقها. قالوا: "مَنْ صَدَقَتْ لهجتُه، صدقت حجّته"([xv]).وبالرغم من مدحهم للصدق والصادق، رأى العرب أنّ "الصّدق في بعض الأمور عجْز"([xvi]).
3- مَنْ ضرَبَ العرب المثل بهم في الصدق:
مِمّن ضرب العرب بهم الأمثال في الصدق:- أبو ذرّ الغفاريّ ([xvii])، وهو جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن بني غفار (...- 32ه/...- 652م): من كِبار الصّحابة ([xviii]).
- حَذام، قالوا: "القولُ ما قالتْ حَذامِ"([xix]). وهي حذام بنت الريّان بن جسر بن تميم، عرفت من أسراب القطا أنّ أعداء قومها يسيرون ليلاً نحوهم، فخرجت تقول (من الوافر):ألا يا قومَنا ارتحِلوا وسيروا فَلَوْ تُرِكَ القطا لَيْلاً، لناما
فقال ديسم بن ظالم الأعصري (من الوافر):إذا قالتْ حَذامِ، فصَدِّقوها فإنَّ القولَ ما قالَتْ حَذامِ ([xx])فارتحل قومها، واعتصموا بالجبل، فيئس أعداؤهم من الإيقاع بهم، فرجعوا عنهم ([xxi]).- الرائد: قالوا: "لا يكذبُ الرائدُ أهْلَه"([xxii])، و"الرائد لا يكذب أهله"([xxiii])، وهو الّذي يقدِّمونه؛ ليرتاد لهم كلأً، أو منزلاً، أو موضع حِرْزٍ، يلجأون إليه من عدوّ يطلبهم، فإن كذِبَهم، أو غرَّهم، أهلكهم. قالوا: "إذا كذب الرائد، هلك الوارد"([xxiv]).- القطاة ([xxv])، وهي نوع من اليمام يؤثر الحياة في الصحراء، ويتّخذ أفحوصه في الأرض، ويطير جماعات، ويقطع مسافات شاسعة ([xxvi]). وللقطاة صوت لا تغيِّره، وصوتها حكاية لاسمها، تقول: قَطا قَطا؛ ولذلك تسمّيها العرب: الصَّدوق ([xxvii]). وقالوا: "أنْسب من قطاة"([xxviii]).كذلك ضربوا المثل في صدق حِسّ الأعراب، فقالوا: "أصدق حِسًّا من الأعراب"([xxix])، وبظنّ الألمعيّ ([xxx])، فقالوا: "أصْدَقُ ظنًّا من الألمعيّ"([xxxi]). قال أوس بن حجر (2 ق.ه/ 620م) (من المنسرح):
الألْمَعيُّ الّذي يظنُّ بكَ الـ ـظَنَّ كأنْ قَدْ رأى وقدْ سَمِعا ([xxxii])
- وعد إسماعيل ([xxxiii])، وذلك لأنّ الله تعالى أثنى عليه بصدق الوعد، فقال: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولا نَّبِيًّا﴾([xxxiv]).(...)**** باحث من لبنان. حائز شهادة دكتوراه في اللغة العربية وآدابها في الجامعة اللبنانية
[i]- الكلّيّات 3/ 109.[ii]- م. ن.، 3/ 110.[iii]- جمهرة الأمثال 1/ 509؛ وزهر الأكم 3/ 159؛ والعقد الفريد 3/ 82؛ ومجمع الأمثال 1/ 342؛ والمستقصى 2/ 115.[iv]- فصل المقال، ص 36؛ ومجمَع الأمثال 1/ 408؛ والمستقصى 1/ 327.[v]- الفاخر، ص 264.[vi]- التمثيل والمحاضرة، ص 243.[vii]- العقد الفريد 3/ 82؛ وفصل المقال، ص 27؛ ومجمع الأمثال 2/ 296.[viii]- مجمع الأمثال 1/ 69. أخلق: أجدر بالتنجية.[ix]- العقد الفريد 3/ 82؛ وفصل المقال، ص 37؛ ومجمع الأمثال 2/ 166.[x]- التمثيل والمحاضرة، ص 243.[xi]- جمهرة الأمثال 1/ 578؛ وزهر الأكم 3/ 251؛ والعقد الفريد 1/ 50، 3/ 119؛ وفصل المقال، ص 448؛ ومجمع الأمثال 1/ 398، 422؛ والمستقصى 1/ 328.[xii]- جمهرة الأمثال 1/ 575؛ وزهر الأكم 3/ 250؛ والعقد الفريد 3/ 83؛ وفصل المقال، ص 40، 41؛ ولسان العرب 10/193، مادّة (صدق)، 13/ 228، مادّة (سنن)، ومجمع الأمثال 1/ 392، 398؛ والمستقصى 2/ 140. والبكر: الفتيّ من الإبل. وأصل المثل أنّ رجلاً ساومَ آخر في بكر. فقال: ما سِنُّه؟ فقال صاحبه: بازِل (هو الّذي طلعت نابه، ويكون ذلك في السنة الثامنة أو التاسعة). ثمّ نَفَر البكر، فقال له صاحبه: هِدَعْ هِدَعْ، وهذه لفظة يُسَكَّن بها الصِّغار من الإبل. فلمّا سمع المشتري هذه الكلمة، قال هذا القول. يريد أنّه صَدَقَ في سنّه، لـمّا دعاه بتلك الكلمة، وقد كان كاذبًا.[xiii]- لسان العرب 2/ 555، مادّة (قدح)؛ ومجمع الأمثال 1/ 398؛ والمستقصى 2/ 140. وسْم القِدْح: العلامة التي عليه تدلّ على نصيبه.[xiv]- مجمع الأمثال 1/ 405.[xv]- التمثيل والمحاضرة، ص 243.[xvi]- مجمع الأمثال 1/ 408.[xvii]- ثمار القلوب، ص 87؛ والعقد الفريد 3/ 70.[xviii]- الإصابة في تمييز الصحابة 7/60؛ والأعلام 2/ 140.[xix]- جمهرة الأمثال 2/ 116؛ وخزانة الأدب 10/97؛ والعقد الفريد 3/83؛ وفصل المقال، ص 41؛ ولسان العرب 12/199، مادّة (حذم)؛ ومجمع الأمثال 2/ 106، 175؛ والمستقصى 1/ 340.[xx]- البيت له في جمهرة الأمثال 2/ 116؛ والعقد الفريد 3/ 83؛ وفصل المقال، ص 4؛ ولسان العرب 12/ 119؛ ومجمع الأمثال 2/ 106؛ ولديسم بن طارق في مجمع الأمثال 2/ 175؛ وللجيم أو لدميس بن ظالم الأعصري في المستقصى 1/ 340.[xxi]- انظر مصادر المثل المتقدّمة.[xxii]- العقد الفريد 3/ 82؛ وفصل المقال، ص 37؛ ومجمع الأمثال 2/ 233؛ والمستقصى 2/ 274.[xxiii]- جمهرة الأمثال 1/ 474؛ والحيوان 4/ 8؛ ولسان العرب 3/ 187، مادّة (رود).[xxiv]- محاضرات الأدباء 1/ 122. والمعنى: إذا كذب الرائد على الورّاد من قومه بإنزالهم في مكان جديب، يتسبّب في هلاكهم.[xxv]- الألفاظ الكتابية، ص 281؛ وثمار القلوب، ص 482؛ وجمهرة الأمثال 1/ 584؛ والحيوان 5/ 573، 7/ 10؛ والدرّة الفاخرة 1/ 265، 2/ 446؛ وزهر الأكم 3/ 251؛ ولسان العرب 2/ 388ـ مادّة (هدج)، 15/ 189، مادّة (قطا)؛ ومجمع الأمثال 1/ 412؛ والمستقصى 1/ 206.[xxvi]- المعجم الوسيط، مادّة (قطا).[xxvii]- مجمع الأمثال 1/ 412.[xxviii]- ثمار القلوب، ص 482؛ وجمهرة الأمثال 2/ 319؛ والدرّة الفاخرة 1/ 265، 2/ 402؛ ومجمع الأمثال 1/ 412، 2/ 347؛ والمستقصى 1/ 391. وأنسب: من النسبة؛ لأنّها إذا صوّتت، عُرفت.[xxix]- خزانة الأدب 11/ 184.[xxx]- الألمعي: الذكيّ المتوقّد الذهن الصادق الفِراسة (المعجم الوسيط، مادّة (لمع)).[xxxi]- جمهرة الأمثال 1/ 584؛ والدرة الفاخرة 1/ 266؛ ومجمع الأمثال 1/ 412؛ والمستقصى 1/ 205.[xxxii]- البيت له في ديوانه، ص 53؛ ومجمع الأمثال 1/ 412؛ والمستقصى 1/ 205.[xxxiii]- ثمار القلوب، ص 45. وإسماعيل هو ابن إبراهيم الخليل من هاجر المصريّة. من نسله العرب المستعربة، أو عرب الشمال بنو عدنان. يعدّه المسلمون من الأنبياء (المنجد الكبير في الأعلام، ص 85).[xxxiv]- مريم 19: 54.الحداثة (Al Hadatha) – س. 29 – ع. 223 - ربيع 2022 SpringISSN: 2790 -1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on May 14, 2022 06:49
May 10, 2022
La Violence Sociale (APPROCHE PSYCHANALYTIQUE)

♦ Désirée Georges AZZI *
- نبذة عن البحث باللغة العربية:
العنف الاجتماعيمقاربة في التحليل النفسي
يساهم العنف بدور أساسيّ في تكوين تاريخ الشعوب، وكان موضوعًا لدراسات كثيرة في ميادين مختلفة: اجتماعية، وسياسية، ونفسية وخاصة من وجهة نظر تحليلية، إذ تشير دراسات التحليل النفسي إلى أن "العنف هو تعبير عن إرادة تحطيم الآخر لامتلاك قوته، وذلك مرتبط بنزوة الموت أو "التاناتوس" (Thanatos).يعالج هذا البحث آراء المحللين النفسيين عن العنف بدءًا من العالم النمساوي سيغموند فرويد (1856 – 1939) مرورًا بالمحللة النمساوية أيضًا، ميلاني كلاين (1882- 1960) وصولا إلى الفرنسي جاك لاكان (1901 – 1981) وغيرهم من المحللين النفسيين، وذلك كي نقف على تحليل ظاهرة العنف وأسباب ازديادها في مجتمعاتنا، فيعالج البحث: أسباب العنف وعوارضه وكيفية التعبير عنه، والوقاية منه، وهل من علاج مقترح في ضوء التحليل النفسي.
- الكلمات المفاتيح: التحليل النفسي، العنف، العدائية، القتل، التحطيم، الخوف، الالتهام، السادية، الشعور بالذنب، اسم الأب، الأنا الاعلى، فرويد، كلاين، لاكان
***- Résumé La violence dans l’histoire des peuples a occupé une place cruciale. Elle a été, de tout temps, sujet d’études dans plusieurs domaines: social, politique, psychologique et surtout psychanalytique, car la psychanalyse la considère comme une expression de la destruction liée à la pulsion de mort «thanatos».En commençant par l’approche de Sigmund FREUD (1939 - 1856), puis en abordant Mélanie KLEIN (1882- 1960) et Jacques LACAN (1901 – 1981), on va essayer, dans cet article, de comprendre la violence, son expression, ses causes, ses manifestations, sa prévention et ses remèdes d’un point de vue psychanalytique.
- Mots-clés: psychanalyse, violence, agressivité, meurtre, destruction, peur, malaise, dévoration, sadisme, culpabilité, Nom-du –Père, Sur-Moi***- INTRODUCTION
Violence et peur visent le même sens, car sans peur il n’y a pas de violence et sans violence il n’y a pas de peur. Il s’agit vraisemblablement d’un fait inhérent à la condition humaine.Dans le cadre de cet article qui a pour thème La Violence, nous avons choisi de parler du désir intense envers l’Autre et de la peur du rejet ou de la possession par cet Autre. En effet, ce sentiment de désir engendre peur et agitation, amenant à la violence. Dans cette perspective nous allons analyser la violence de point de vue analytique en faisant le lien entre violence et peur suivant l’analyse de Freud et de Klein et dégager une perspective de remède.Et dans ce cheminement, nous revenons à ce que S. FREUD a écrit, dans son livre Malaise dans la civilisation, sur «le combat entre l’Eros et la mort, entre la pulsion de vie et la pulsion de destruction, tel qu’il s’accomplit dans l’espèce humaine»: «En somme, ce conflit est le fond essentiel de l’existence et pour cela, l’évolution de la civilisation peut bien être qualifiée de combat de l’être humain pour la vie. Et nos nourrices voudraient apaiser cette lutte colossale en chantant des berceuses» (Freud, 2010, p. 134)L’organisation mondiale de la santé définit la violence comme l’utilisation intentionnelle de la force physique, de menaces à l’encontre des autres ou de soi-même, contre un groupe ou une communauté, qui entraîne ou risque fortement d’entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un décès.Dans ce cadre, il faut mentionner que les deux expressions violence et agression désignent l’intention de faire du mal. Mais en tant que démarche persuasive ou défensive, l’agression peut prendre une valeur adaptative et devenir indispensable à la survie de l’individu ou de l’espèce; ce qui n’est pas le cas de la violence. «Rien ne peut justifier un acte de violence. Toutes les violences sont des agressions, mais toutes les agressions ne sont pas des violences» (PAHLAVAN, 2002, p.7)(...)***
* ديزيره جورج القزي: بروفيسورة، دكتوراه في علم النفس العيادي والمرضي- محللة نفسية. أستاذة محاضرة في الجامعة اللبنانية – كلية الآداب والعلوم الانسانية (الفرع الثاني)، رئيسة قسم علم النفس لسنتين (2019-2021)، ممثلة للأساتذة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية (الفرع الثاني) حاليًا. لها عدة كتب وأبحاث منشورة. عضوة في الـ"Espace Analytique".
* Désirée Georges AZZI: PR Désirée Georges AZZI Dr en psychologie clinique et psychopathologie – Psychanalyste. Professeur à l’université Libanaise à la faculté des lettres et sciences humaines section 2, chef de département de psychologie 2019-2021. Actuellement, représentante des professeurs à la section 2. Auteur de plusieurs ouvrages et articles. Analyste praticienne à Espace Analytique.
- BIBLIOGRAPHIEBibleBergeret-Amselek, C. (1998). Le mystère des mères. Paris: Ed. Desclée de BrouwerDoron, R.; Parot, F. (1998). Dictionnaire de la psychologie. Paris: Ed. P.U.F.Freud, S. (2000). Le malaise dans la culture. Paris: Ed. P.U.F.Freud, S. (2001). Totem et tabou. Paris: Ed. PayotFreud, S. (2010). Malaise dans la civilisation. Paris: Ed. PayotFreud, S. (2012). Actuelles sur la guerre et la mort et autres textes. Paris: Ed. P.U.F.Klein, M. (2001). L’amour et la haine. Paris: Ed. PayotKlein, M. (2004). Deuil et dépression. Paris: Ed. PayotMaalouf, Joseph. (2014). Amin Maalouf itinéraire d’un humaniste éclairé. le Harmattan (E-BOOK)MICHAUD, Y. (2010). la violence. Paris: Éd. P.U.F.PAHLAVAN, F. (2002). les conduites agressives. Paris: Ed. Armand ColinPORGE, E. (1997). Les Noms du père chez Jacques Lacan. Toulouse: Eres
الحداثة (Al Hadatha) – س. 29 – ع. 223 - ربيع 2022 SpringISSN: 2790 -1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on May 10, 2022 00:54
معايير الإثارة في الصحافة الرقمية السياسية اللبنانية (نماذج مختارة)

♦ طوني بولس عيسى *

- نبذة عن البحث
ثمة مَن ينظر بقلق إلى ما يمكن أن تؤول إليه "الفورة الرقمية" في مجال الإعلام. ويعتقد البعض أن في الإعلام الرقمي كثيرًا من التفلُّت من ضوابط المهنة والمسؤولية الاجتماعية، ويخشى أساليب الإثارة التي تظهر في العديد من المواقع الإلكترونية، بهدف اجتذاب المتابعين أو خدمة لبعض المصالح. فإذا كان الرقميُّ هو المستقبل، و"سيَرِث" الصحافة بأدواتها الثلاث، المطبوع والمسموع والمرئي، فأي إعلام سيكون؟ وما عناصر الطمأنينة، في مقابل هذا القلق؟في هذا البحث، محاولة لتقديم بعض الأجوبة من خلال دراسة لمواقع رقمية في لبنان، هي: "ليبانون ديبايت"، و"ليبانون 24" (موقعان إلكترونيان)، و"الأخبار" و"الجمهورية" (موقعان إلكترونيان لجريدتين تصدران ورقيًّا).
- الكلمات – المفاتيح: الصحافة الرقمية، الإعلام اللبناني، مواقع إلكترونية
***
يومًا بعد يوم، ترسِّخ المواقع الإخبارية الرقمية حضورها كوسائل إعلام جماهيرية، أي كمؤسسات تنشئة اجتماعية(1). في المقابل، تتنامى شكوى ناشري الصحف المطبوعة من تراجع انتشارها وإهمالِ الجمهور لها. ويعبّر دخول الإعلام في العصر الرقمي عن تطوّرٍ في عناصر المجتمع ككل، وفي فَهم هذا المجتمع لنفسه وآليات التعبير عنها. وسبق أن حصل مثل هذا التطوّر عند دخول الصحافة جيل الراديو، ثم جيل التلفزيون. فالتطوُّر في الأداة والشكل يعني التطوُّر في المضمون، والشكل والمضمون يتداخلان، والتغيُّر في أحدهما يحتِّم التغيُّر في الآخر. و"الوسيلة هي الرسالة" كما يقول ماكلوهان (McLuhan)(2).لقد أحدث الإعلام الرقمي تحوُّلًا في أشكال التعبير الصحافي ومضامينه. وسمحت التكنولوجيا التي يستخدمها لكثيرين، من فئات وبيئات وشرائح اجتماعية وثقافية مختلفة، بإنشاء مؤسساتهم الصحافية والتعبير من خلالها عمّا يخطر لهم، وفي شكل إفرادي أحيانًا، ومخاطبة الملايين. وساهم التطوُّر التكنولوجي السريع بالحؤول دون وضع ضوابط قانونية دقيقة للإعلام الرقمي، كتلك التي تُلزِم المؤسسات الصحافية الكلاسيكية. وفيما كان الإعلام حكرًا على ذوي الطاقات المادية، من أفراد ومؤسسات وأحزاب وحكومات، وكان تأسيس صحيفة أو إذاعة أو تلفزيون وتشغيل أي منها يحتاجان غالبًا إلى أموال طائلة، فقد أتاحت شبكة الإنترنت إنشاء مؤسسة إعلامية بمقدار من السهولة. وفوق ذلك، بات الموقع الإخباري الرقمي يجمع النصّ المكتوب والتسجيل الصوتي والفيديو وينقل البثّ مباشرة، ويتيح للمتلقّي إعادة الاستماع والمشاهدة والتفاعل الفوري مع المرسل، وهو أمر تعجز الصحيفة والراديو والتلفزيون عن تحقيقه.هذا "الإغراء" دفع الكثيرين إلى الانخراط في المغامرة المفتوحة، خصوصًا أن مخاطرها المادية محدودة. فإذا نجحت، تُحقق لهم الحلم بإنشاء مؤسساتهم الصحافية الخاصة، "الخارقة" بفاعليتها وانتشارها، والمرشّحة لتصبح مشاريع ذات مردود معنوي أو مادي. وهذا "الإغراء" أحدث "الفورة" لتأسيس مواقع إخبارية إلكترونية. ولا يقتصر الأمر على الصحافيين "المحترفين"، بل يتعداهم إلى أفراد من بيئات وفئات مختلفة يحدوهم الطموح إلى خوض غمار التجربة. ويدور بين هؤلاء جميعًا تنافس حادٌّ للفوز في السباق لبلوغ المراتب الأولى في نسبة المتابعة جماهيريًّا، ما ينعكس ازدهارًا للموقع وشهرة ونفوذًا لأصحابه وإعلاناتٍ ومالًا في الجيوب. هذا التسابق يتسبب بسخونةٍ تبلغ الذروة، وفيها يستخدم كل متنافس ما يتاح له من أدوات للقول: "أنا هنا"، والأداة الأبرز هي المادة الصحافية نفسها.لذلك، كثيرًا ما يلجأ المتنافسون إلى الإثارة المبالَغ فيها في العناوين والنصوص والصور والأفلام، بهدف لفت الانتباه واجتذاب الجماهير وإثبات الحضور. وقد "وفّرت الصحافة الإلكترونية بيئة خصبة لانتشار الشائعات والأخبار الكاذبة بسرعة غير معهودة في الصحافة المطبوعة". وهذه السرعة تسببت أحيانًا بعدم القدرة على التأكد من صحة المعلومات، وهو ما حافظ على ثقة أكبر في الصحف المطبوعة. يضاف إلى ذلك، أن المادة في الصحافة الرقمية قد يجري تداولها من خلال عمليات "النقل غير الأخلاقي" مهنيًّا (3).هنا تكمن إشكالية هذا البحث: في غمرة التسابق الساخن على الإثارة والجذب، ما مدى مراعاة المواقع الإخبارية الإلكترونية للمعايير والأخلاقيات المهنيَّة؟ واستتباعًا يُطرح السؤال: في خضم التفاعل القائم بين الورقي والرقمي، أي معايير إثارة ستكون لها الغلبة؟ وإذا كانت الصحف الورقية إلى انحسار، فهل ستموت أيضًا معاييرها المنضبطة وتسود معايير أكثر تفلتًا؟ هذا ما يعالجه البحث من خلال دراسةٍ استهدفت عيّنةً من المواقع الإلكترونية، الإخبارية السياسية، في لبنان.
- منهجية البحث
يعتمد البحث أربعة مواقع لبنانية إخبارية سياسية موزَّعة كالآتي: موقعان إلكترونيان هما: "ليبانون ديبايت" (يميل إلى "14 آذار") و"ليبانون 24" (يملكه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي)، وموقعان إلكترونيان لجريدتين تصدران ورقيًّا هما: "الأخبار" (يسارية وحليفة لـ"حزب الله") و"الجمهورية" (يملكها وزير الدفاع السابق إلياس المرّ). وامتدت الفترة المشمولة بالبحث أسبوعًا من الإثنين 4 نيسان (أبريل) إلى الأحد 10 نيسان 2022. وجرى اختيار هذه الفترة لأنها تلائم الإطار الزمني الذي تمَّ فيه إجراء البحث، ولأنها تميَّزت في لبنان بتطورات سياسية واقتصادية مُهمَّة، وأبرزها تبلور الخريطة النهائية لمعارك الانتخابات النيابية بعد اكتمال عقد اللوائح المسجَّلة رسميًّا، وتوقيع الاتفاق الأوَّلي بين لبنان و"صندوق النقد الدولي" (IMF) بعد مفاوضات استمرت نحو عامين.اُتبعت الآلية الآتية لدراسة العيّنة: الرصد اليوميّ لمجمل الأخبار والتقارير والمقالات والتحقيقات التي نشرتها المواقع الأربعة، انتقاء 120 عيّنة عشوائية (30 لكل منها) موزّعة ضمن ثلاث فئات: المواضيع السياسية والأمنية (10)، والمواضيع الاقتصادية والمعيشية (10)، والمادة الصحافية المتعارف عليها في الصحف والمواقع الإخبارية في لبنان بأنها "منوَّعات غير سياسية"، وتضم إجمالًا أخبار الفن والمجتمع والمشاهير والصحة (10). وجرى تحليل أساليب الإثارة التي اعتمدها كل موقع في كلّ من الفئات الثلاث، وتمَّت مناقشة المُتغيِّرات فيها وبناء الاستنتاجات.(...)***
* باحث وكاتب سياسي، يعدّ أطروحة دكتوراه في الإعلام وعلوم الاتصال - المعهد العالي للدكتوراه في الجامعة اللبنانية
1- آمال موسى، مقاربات علم الاجتماع الوظيفي والنقدي لوسائل الإعلام - 2014، (تاريخ الزيارة 5 نيسان 2022): http://socio-logie.blogspot.com/2014/07/blog-post_9957.html2- Marshall McLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man: Critical Edition, Gingko Press, 2013, p. 193- علي عبد الفتاح، الصحافة الإلكترونية في ظل الثورة التكنولوجية، دار اليازوري، عمّان 2014، ص 31- 324- اسماعيل عزّام، هندسة المقال في البناء الصحافي، موقع "الجزيرة"- 2016، (تاريخ الزيارة 5 نيسان 2022):https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/5795- Sandra J. Ball-Rokeach & Melvin L. DeFleur, Theories of Mass Communication, 5th Edition, New York; London, Longman, 1989, p275-2766- مي العبد الله، نظريات الاتصال، ط2، دار النهضة العربية، بيروت 2010، ص265- 266.7- محمد حسام الدين، المسؤولية الاجتماعية للصحافة، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة 2003، ص 62- 638- أحمد أبو زيد، مدخل إلى البنائية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة 1995، ص 379- خالد محمد غازي، الصحافة الإلكترونية- الالتزام والانفلات في الخطاب والطرح، وكالة الصحافة العربية، القاهرة 2007، ص 231
الحداثة (Al Hadatha) – س. 29 – ع. 223 - ربيع 2022 SpringISSN: 2790 -1785 الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on May 10, 2022 00:36
May 9, 2022
التسويق الشبكي المفهوم والنشأة والتكييف الفقهي

♦ محمد حسن علوان*
نبذة عن البحث
يشهد العالَمُ - جرَّاءَ التطورِ السريعِ في عالم الاتصالات- ظهورَ الوسائل الإلكترونية واستخدامها في المجالات كافة، حتى أصبحت وسائلَ لا يمكن الاستغناءُ عنها لكل فرد في المجتمع الحديث، وصارت معظم الإجراءات التعاقدية تتم من خلال الأنظمة الإلكترونية، بوصفها البديلَ العصريَّ للتعاقد عن طريق المراسلة والبرقيات العادية، وذلك لاتسامها بالسرعة والدقة في إجراء العقود، وسهولة إثباتها بالطرق الإلكترونية. ومن هذه العقود الجديدة عقدُ "التسويق الشبكي" (**(MLM، ولا بدّ لكل حادثة من الحوادث المستجدة، تصور، ثم تكييف شرعي، ثم حكم شرعي.مع التطور المتزايد والمتسارع إذًا، في سوق المعاملات التجارية، ونظرًا إلى حاجز المسافة والزمن بين طرفي المعاملة، كان لا بدّ أن يزود الأفراد بوسائل تعاقد حديثة؛ تعمل على الاقتصاد في النفقات، وتسريع التعامل، وإبرام العقود في ثوان أو دقائق معدودات، وهذا ما يسعى البحث إلى معالجته من خلال معالجة إشكالية التسويق الشبكي ومفهومها ونشأتها من جهة، والتكييف الفقهي من جهة أخرى.يقسّم البحث مبحثين وخاتمة:المبحث الأول يتضمن مطلبين: الأول: مفهوم التسويق الشبكي، والثاني: نشأة التسويق الشبكي.ويتضمن المبحث الثاني مطلبين أيضًا: الأول: التعريف بأهم الشركات التي تعمل بنظام التسويق الشبكي، والثاني: التكييف الفقهي لمعاملة التسويق الشبكي.أما الخاتمة فأبرزت جديد البحث وأهم النتائج والخلاصات.***
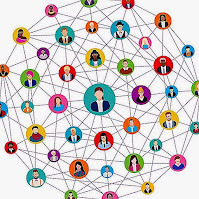
- المبحث الأول- المطلب الأول: مفهومُ التسويقِ الشبكي
التسويق الشبكي هو برنامجُ تسويقٍ يحصل فيه المسوِّق على عمولات أو حوافزَ ماليةٍ نتيجةً لبيعه المنتجَ أو الخدمة، إضافةً لحصوله على عمولات من كل شخص يتم اعتماده كمساعد أو تابع للمسوق، وفق أنظمة وبرامج عمولات خاص([i]).التسويقُ إذًا، هو دعاية وإعلان، ويتم التسويق عبر شبكة الإنترنت بحصول المسوّق على موقع خاص (مساحة)، يسوّق من خلالها لبضاعة الشركة.قديمًا كانت تتم الدعايةُ والإعلانُ عن طريق وسائل بدائية بسيطة تقوم على التسويق المباشر عن طريق السمسار الذي يعرض البضاعة على الزبائن ويرغّبهم بها، لكن في هذا العصر حاول الباحثون في مجال التسويق تحويلَ هذه الطريقة إلى نظام تسويق متكامل، يدفع العميل إلى التحرك والترويج ونشر المنتجات مقابل امتيازات خاصة. وبالفعل نَشَأَ علمٌ جديدٌ سمي "التسويقَ الشبكي" أو "شبكات التسويق"، أو "التسويق متعدد الطبقات". من هنا جاء الاسم بالتسويق الشبكي (أي: عبر الإنترنت).وزيادةً للتوضيح: إذا اشتريت منتجًا (سلعة أو خدمة) من هذه المنشأة، فإنك تصبح في الوقت نفسه عضوًا في شبكة تسويقية، بحيث إذا تمكنت من جلب عدد من الزبائن لهذه المنشأة، يساوي تسعة على الأقل، فإنك تستحق عمولة معينة، ثم إن كلّ زبون من هؤلاء سيسعى أيضا إلى جلب زبائن آخرين، على هذه الشاكلة، وتزداد العمولة وتتضاعف كلما زاد عدد الزبائن، وعلى هذا الأساس، قد تحصل على العمولة وقد لا تحصل، وقد تحصل على عمولة كبيرة أو صغيرة([ii]).والتسويقُ الشبكي له اتجاهات ومفاهيمُ تختلف من شركة إلى شركة، فيمكن أن يتضح جليًّا عند الكلام عن الشركات التي تعمل بهذا النظام.
- الملخص لمفهوم التسويق الشبكي
يتَّضح أنَّ التسويقَ الشبكي عبارةٌ عن شراء أو اشتراك (على حسب الشركة) يتم من خلاله أخذ العضوية من الشركة وهو (عقد) يصبح المشارك أو المشتري مسوقًا للبضاعة، ويمكن أن نسميه "سمسارًا".لهذا العقد شرط وهو: لا يحقّ للمشترك الحصول على ربح إلا بأن يقنع تسعة أشخاص للشراء أو الاشتراك من منتج الشركة، فإذا وصل العدد إلى تسعة استحق عمولة معينة معلومة. وهكذا فكلما زاد عدد الأعضاء الذين اشتركوا عن طريقه ازدادت عمولته.والتسويق الشبكي يسمّى بالتسويق الهرمي، وسيتضح سبب تسميته بالتسويق الهرمي عند الحديث عن الشركات التي تعمل بهذا النظام، وسنرى مفهوم التسويق الشبكي أكثرَ إيضاحًا وجلاءً بعد الحديث عن الشركات التي تعمل به.
- المطلب الثاني: نشأةُ التسويقِ الشبكي (...)***
* باحث من ليبيا. حائز شهادة دكتوراه في الفقه المقارن في كلية الدعوة الجامعية للدراسات الإسلامية في لبنان ** التسويق الشبكي: Multi-level marketing، ويختصر بـ""MLM، ويسمّى أيضًا بـ"Network Marketing"
([i]) أسامة عمر الأشقر، التكييف الفقهي لمعاملة التسويق الشبكي، مؤتمر كلية الشريعة السادس، جامعة الزرقاء الأهلية - الأردن.
([ii]) فقه المعاملات المالية، رفيق بن يونس المصري، ص 306، التجارة الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي، علي محمد أبو العز، ص 264، التسويق الشبكي، محمد حزواني، ص17 و18.
الحداثة (Al Hadatha) – س. 29 – ع. 223 - ربيع 2022 Spring
ISSN: 2790 -1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on May 09, 2022 14:30
مراجعات: كتاب جديد للكاتب فرحان صالح : إله بأسماء كثيـرة - في نقد المرويات المؤسسة للفكرين الديني والقومي



صدر لرئيس تحرير مجلة الحداثة اللبنانية الكاتب والمفكر فرحان صالح كتاب جديد تحت عنوان: إله بأسماء كثيـرة - في نقد المرويات المؤسسة للفكرين الديني والقومي *، وجاء في 343 صفحة من القطع الكبير، ورقم الإيداع: "7127 / 2022".قدّم للكتاب المفكر والباحث د. جورج قرم، والعالم الاجتماعي المفكر والأكاديمي والموسوعي د. خليل أحمد خليل.
المثقف العربي المتأصل
تناول قرم في كلمته: "فرحان صالح: مثال المثقف العربي المتأصل"، أنه "ليس من السهل وصف أعمال فرحان صالح الموسوعية الطابع، فهو مثقف متعدد الأوجه والاهتمامات ذات الطابع الانتروبولوجي في إطار نزعة حداثوية معمّقة". وأضاف: "من هنا عمق التحليل عنده ودائمًا في إطار حداثوي النزعة. وهو قد أسس مجلة الحداثة التي أثرت الثقافة اللبنانية والعربية حيث تناولت مواضيع مختلفة تتعلق بالوعي القومي العربي وهموم الثقافة وقضايا الهوية والتراث. كذلك أصدر العديد من الكتب التي تناولت مواضيع مختلفة حول الثقافة العربية والهوية والتراث، المادية والوعي القومي عند العرب، وتطور المسألة الوطنية في لبنان بالإضافة إلى الإضاءة على الصناعات الحرفية... إلخ".وذكّر قرم بأن صالح "نظم سلسلة مؤتمرات حول الثقافة الشعبية في لبنان والشعر العامي، كذلك ساهم في المؤتمرات حول الثقافة الشعبية العربية في مصر. وله خمسة عشر مؤلفًا بمواضيع مختلفة تدلّ على مروحة اهتماماته الواسعة، وعلى اتجاهه الانتروبولوجي الذي يسود كتاباته"، مشيرًا إلى أنه عندما نستعرض عناوين مؤلفات صالح "يمكن أن نرى المروحة الواسعة لاهتماماته من قضايا جنوب لبنان إلى قضايا الوعي القومي عند العرب وجدلية العلاقة بين الفكر العربي والتراث ومشاكل الهوية العربية. ذلك يمكن أن نصف فرحان صالح بـمثال المثقف العربي المتأصل سواء في بيئته القطرية أم في وعيه القومي العربي. وقد جاء هذا المؤَلَف تتويجًا لقدراته البحثية ومسيرته الطويلة في الغوص في أعماق الوطن العربي السياسية والشعبية والثقافية".
بين الوهم والعلم
أما خليل فتحدث في كلمته عن "الفصْل بين الوهم والعلم"، ورأى في مقدمته للكتاب، أن أعمال فرحان "تجمع وتطرح معطيات عصرنا الثقافية، في محاولة جادّة للفصل بين الوهم والعلم، أعني بين الخيال والبحث الواقعي، وليس حصرًا بين الدّين أو السحر أو الأدب الأسطوري، والعلوم".وقال خليل: "في "إله بأسماء كثيرة..."، يأخذنا فرحان صالح إلى البحث عمّا يحدث حين يصطدم الوهمُ بالعلم، الكورونا الميثولوجية بالمختبرات والتكنولوجيّات. صحيح أن كتاب صالح يدور حول الديانات الميمية الثلاثية (موسى/ المسيح/ محمّد)، وتحديدًا حول الأساطير التي أنشأتها، والإيديولوجيات الصقلوبية أو ذوات العين الواحدة، والأحزاب أو الدول التي نبتت على ضفافها المتباعدة تارةً، والمتصادمة تاراتٍ. ولكن هذا لا يمنع من أن يسهم عملُه العلمي في التمهيد لسوسيولوجيا، بل لأنثروبولوجيا دينية، على مستوى الكوكب – حيث تتصادم ظهاريًّا (في العلن والخفاء) نحو عشرة آلاف جماعة عرقيّة، وتتداولُ حوالى ستة آلاف لسان/ لغة/ لهجة، على ناسيّات دينية/ سحرية/ أسطورية تفوق الأربعة آلاف؛ ولكل دين أو ديانة منها إله أو إلهة – ولكن لو سُمّيت الآلهة الشخصية واللاشخصية بآلاف الأسماء، لبقي لكل جماعة ثقافية إله خاص بها، طالما أن مفتاح العقد يتحوّل – عندها – إلى قُفل اعتقادي".وأكد خليل أن أعمال صالح "ستشكل إضافةً إلى المساهمات النقدية في تعرية العقبات المعرفية التي تعترضُ، فلسفيًّا، التكوين العلمي للعقلانية العربية المقبلة من وراء الحرائق الراهنة. ومن هذه العقبات نذكر، للمثال، الثلاثية التُّرهية (زندقة، هرطقة، علمنة)، التي حوّلت التنوير العربي والإسلامي إلى تدمير شبه كامل؛ ولكن الأمم الكبرى، في مداراتها الحضارية، تحتاج إلى قرون وأجيال لكي تخرج من كهوفها إلى أنهار تطوّرها وتقدّمها عالميًّا".وخلص خليل في تقديمه لكتاب فرحان بالقول: "هذا بحثٌ موثقٌ بمئات المصادر المرجعيّة، العربية والأجنبية، وموثوقٌ من حيث الاستفادة والإفادة على صعيد فلسفة العلوم. هل نجح فرحان صالح، هنا والآن، في الفصل العقلي بين الوهم والعلم؟ هل أحسن، هل أساء؟ هذا ما سيحكم عليه قارئ الحاضر وباحث المستقبل. أما أنا، وقد كتبتُ ما كتبت، وزرعتُ مخطوطات ختمتُها برسوم فكرية، وتقاعدتُ، فإنني أشكر للصديق الكريم إمتاعي بقراءة كتابه قبل نشره، وأتمنى له، ولعائلته، المزيد من الإزهار والإثمار".
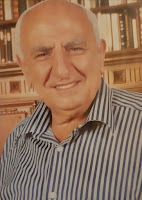
مقاربات جديدة في نصوص مقدسة وتراثية
ضمّ كتاب فرحان ثلاثة أقسام، وكل قسم شمل عدة فصول ومباحث وخلاصة، ومكتبة بحث قُسّمت إلى مراجع عربية ومعربة وأجنبية.ومما عالجه الكتاب في قسمه الأول الذي جاء تحت عنوان: "مرويات الأساطير في الفكر الديني - مقاربات جديدة في نصوص مقدسة وتراثية"، الفصول والمباحث الآتية: المعلمة الأولى والتحولات الكبرى، أولًا: جدلية الاستقرار والتشرد، وتناول: حواء تدجن آدم، والروح الممتدة في الطبيعة، ومن الأمومي إلى الأبوي، ونظرية داروين: البقاء للأقوى، وأمومي مشاعي – أم رأسمالي؟، والجذور الحضارية المؤسسة، وديانة حواء، والتفاحة واكتشاف المجهول، والأرض الخضراء وأشجار الخريف. وضم القسم أيضًا: ديوك السماء، وفي الأيديولوجيا والدين، والمدماك التأسيسي والبعد الميتافيزيقي، وموسى ويهوه، وصورة الإله الأول، وتجاوز المقدس بواسطة المقدس؟، والإله المكتفي في ذاته، والتقاويم الزمنية، وهيكل سليمان، والمسيح – السيره التقليدية، وصورة جديدة لعلاقة الله بالبشر، وعيسى/ يسوع/ المسيح... آدم الجديد، والأديان في أوهامها وتناقضاتها؟، ومرجعية الماضي وإقفال الاجتهاد. كذلك شمل القسم: مقاربات في السلوكيّات والتعاليم الدينيّة. وتطرق إلى التاريخ الديني بين العلم والخرافة، والموروثات الدينية حول آلهة الأرض، وتقلبات الطبيعة الولاّدة للخوف والدين، والأساطير الثلاث، والكيفية التي رسمت فيها الأديان الطرق للسيطرة (التجربة العبرانية)، والجنّة والنار- السلطة للسماء أم للأرض؟، والشك في مواجهة الخوف ("قرطاج" المدينة التي أسست لامبراطورية عالميّة)، وفلسطين في العهد الروماني، والأسس الأولى للتطرف الديني (مقاربة في السلوكيات الدينيّة)، والمسيحيّة حالة تجاوز التعاليم التوراتيّة والتقاء مع الأم الأرض، وولادة المسيحية وانكفاءة التوراة، وعودة إلى التراث العبري – اليهودي.وتحت عنوان: "حينما تصبح الأسطورة تاريخًا يؤرخ به!"، عالج صالح: البحث في التاريخ عن اليهودية والمسيحية والإسلام، وأسطورة يهوه، وأساطير الأولين في تراث المسلمين، والمشروع المحمدي (المخاض والتمظهر والنماذج المعبرة عنه)، وأفول تقاليد وولادة أخرى بثوب جديد، ودور المرأة في الحدث الإسلامي، والأسطورة ترسم التاريخ: تحولات الحدث المحمدي، والتاريخ الإسلامي: قراءة جديدة، واللغة بداية لا خاتمة، واللغة والدين: الآرامية - السريانية لغة الوحي الديني والاجتماع البشري؟، والآرامية السريانية لغة التفاهم بين سكان الجزيرة والمشرق، والخلفية العقائدية لمحمد، وجبريل ونزول الوحي، ومشاركة اليهود والمسيحيين في المشروع المحمدي وعودة إلى السيرة الذاتية للرسول، والمشروع المحمدي بعد موت الرسول؟، واغتيال عثمان والعودة إلى حكم العائلة.
- في نقد الفكر القومي
في القسم الثاني من الكتاب الذي جاء تحت عنوان: "القومية بجلباب ديني - في نقد الفكر القومي"، بحث صالح في: مقولات النهضة والفاشيات الجديدة، والأوهام غير المسوغة، والعروبة ليست دينًا، والموقف القومي من الأقليات القومية.وتناول النظام الرأسمالي والخطاب العربي السائد، طارحًا على بساط البحث سؤال: قومية أم قوميات، والحداثة حاجة دينية؟، دارسًا عدة قضايا منها: التمسك بالتراث الماضوي، وقصور المشروعات، والأيديولوجيات السائدة، وروّاد الإصلاح الديني ومعضلة النهوض، وأزمة العقل العربي، وواقع المسلمين والحاجة إلى النقد الذاتي، ورؤية للإصلاح الديني، والحاجة إلى ثقافة إصلاح ديني، والإسلام والنهضة الحضارية المنشودة، والعقل أولًا، والواقع هو الأصل، والتفكير العلمي طريق التطور، والتفاعل الحضاري بين الشرق والغرب، والدين: قراءة جديدة.وركز صالح على إشكالية: "عروبة مواجهة أم عروبة موادعة؟"، ومما عالجه في هذا الإطار الموضوعات الآتية: زريق وخليل ورؤيتاهما للمسألة القومية، والفكر العربي والمسألة الدينية، والفكر القومي ودينامية الاستبداد، والقومية بجلباب ديني، والدوري – عمارة: ثنائية العروبة والإسلام، والجابري وسؤال الهوية، وقراءة جديدة للتاريخ العربي، والأمة العربية - المسألة القومية. وفي فصل طرح معادلة: "بين ثقافتي الرعي والمعلومات"، متوسعًا في الحديث عن: المسألة الثقافية، والثقافة والتثاقف والتنوع الثقافي، والثقافة والثقافة الشعبية، والثقافة الاستهلاكية والمصالح الاستعمارية، والثقافة والعولمة، والعولمة والصناعات الثقافية، ومن عصر الرعي إلى عصر المعلومات.
ثوابت "آلهة" التنوير والنهضة
أما القسم الثالث من كتاب صالح فجاء تحت عنوان: "ثوابت "آلهة" التنوير والنهضة وتحديات تجاوز الجمود والمراوحة"، وعالج فيه: رجالات النهضة العربية ونساؤها، ودور الجمعيات الأهلية، والطهطاوي بين النهوض والعودة إلى التقليد، ومحمد عبده بين التراث والمعاصرة، وقاسم أمين ومسألة تحرير المرأة، والطاهر الحداد والحركة العمّالية، والمجلات النسائية، وتأسيس الخطاب النسائي، وعلال الفاسي والتوفيق بين الاجتهادات، وزينب فواز: خطاب نهضوي تأسيسي، وملك حفني والتغيير من الداخل، ونظيرة زين الدين ومسألة السفور والحجاب. وبحث القسم أيضًا في: "انكسار المشروع النهضوي وإخفاقات الحداثة".ومن الموضوعات التي طرحها صالح في كتابه أيضًا: جدل الدين والحداثة، ومآلات الدين في العالم الغربي، ومأزق الدين في العالم العربي، وجدل تيارات الفكر العربي الحديث، والولاية والخلافة بين السنة والشيعة، وتاريخية الدولة: من السلطة النبوية إلى السلطة الرعوية، ونحو صياغة عصرية للمجتمعات العربية، ومخاضات النهضة والألفية الثالثة، والحركات الإصلاحية ومؤثرات عصر النهضة، والأصولية والثورات العربية، والمشهد العربي بعد 2011.وتحت عنوان: "الغرب والمسلمون"، قدم صالح: "أربعة مشاهد في الخطابات الأيديولوجية الغربية"، منها: ماذا بقي من عصر التنوير؟، والخطاب الغربي... تجديد للتمايز والسيطرة (خطاب الكراهية)، وفلسطين الضائعة بين "الشعب المختار" و"خير أمة أخرجت للناس".
- بلورة فكر عربي جديد
يشار إلى أن كتاب فرحان صالح الجديد يأتي استكمالاً لمشروعه الثقافي والفكري الذي دأب عليه في معظم مؤلفاته وكتاباته في السياسة والاجتماع والتاريخ والثقافة، فضلاً عن مساهمته في تأسيس دار الحداثة لنشر الفكر التنويري والحداثي، ومجلة الحداثة الفصلية المحكمة، وحلقة الحوار الثقافي مع مجموعة من المفكرين والمثقفين في لبنان والوطن العربي. فصالح في معظم كتاباته، يركز على نقد العقلية العربية الانهزامية، بهدف بلورة فكر عربي جديد يخرج من ثقافة الوهم والخرافة والاستسلام، إلى ثقافة العلم والمعرفة والوعي. وقد تجلى ذلك في عشرات المقالات والحوارات والأبحاث والدراسات والكتب التي نشرها حتى الآن. ومن أبرز مؤلفاته: جنوب لبنان: واقعه وقضاياه - 1973، والثورة الفلسطينية وتطور المسألة الوطنية في لبنان: حول أحداث لبنان – 1975، والمادية التاريخية والوعي القومي عند العرب: (الجذور) - 1979، والحرب الأهلية اللبنانية وأزمة الثورة العربية –1979، وجدلية العلاقة بين الفكر العربي والتراث – 1979، ولغة الجنوب (رؤى أدبية) - 1984، وهموم الثقافة العربية (1) – 1988، و(2)- 2007، وفي الهوية والتراث – 2002، والحياة المغدورة أو المسرح والسياسة – 2010، وكفرشوبا: قصة حب... سيرة مكان، في طبعتين: 2006 و2015، ورسائل حب إلى جانيت (رواية جيل) – 2008، والتراث والتاريخ: قراءات في الفكر التاريخي: عند جمال حمدان - جواد علي - أحمد صادق سعد - عادل ومنير إسماعيل - عبد القادر جغلول - كمال الصليبي - 2015، وحول تجربة الإخوان المسلمين: من جمال عبد الناصر إلى عبد الفتاح السيسي - تقديم السيد يسين - 2015، و"محمد علي وعبد الناصر: ارتسامات النهوض العربي: الصعود والانكسار، 1805-2013" – 2018.**** صالح، فرحان (2022). إله بأسماء كثيرة – في نقد المرويات المؤسسة للفكرين الديني والقومي. (تقديم: د. جورج قرم، ود. خليل أحمد خليل. لوحة الغلاف: مروان زهران). ط. 1. بيروت (رقم الإيداع: 7127 / 2022).
الحداثة (Al Hadatha) – س. 28 – ع. 221 – 222 - شتاء 2022 WinterISSN: 2790 -1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on May 09, 2022 04:01
•
Tags:
alhadatha, مجلة-الحداثة
May 8, 2022
الشخصية النسائية التاريخية في البناء السردي - مقاربة موضوعاتية لـ"شمس" محمد حسين بزي


♦ خديجة عبد الله شهاب *
"المرأة توجد مرة واحدة في عمر الرجل". الروائي الفلسطيني غسان كنفاني
نبذة عن البحث

يسعى البحث إلى تناول فاعلية الشّخصيّة التّاريخيّة في بناء العمل الروائي، وقد اختار البحث رواية الكاتب اللبناني محمد حسين بزي ([1]) "شمس" ([2]) الصادرة حديثًا، كأنموذج لتقديم مقاربة تسلط الضوء على حقبة من التاريخ اليمني القديم؛ وتحديدًا دور المرأة فيها؛ وذلك بالاستناد إلى المنهج الموضوعاتي (Thématique) وفي المستويين العسكري والاجتماعي، ويحصر البحث عمله في المنهج الموضوعاتي في الموضوعاتيّة المعجميّة، حيث يتعيّن أن يكتشف الكلمات- المفاتيح، ويقرأها في سياقها، وفي دلالتها التي تحملها في الموقع الذي وردت فيه ([3]). وفي هذا السياق، لن يغفل علاقة هذه الكلمات بما قبلها، وما بعدها، ويقف بداية عند مراقبتها، ومن ثم وصفها؛ وتحليلها على أن يلجأ إلى الكشف عن دلالتها في معانيها التّعيينيّة والتّضمينيّة، ومن ثم يقرأ علاقة الشّخصيات ببعضها في مستوياتها الاجتماعيّة والنّفسيّة.يفتحُ البحث الباب إذًا، على زمن مضى عليه ما يزيد على ثلاثة الآف عام، يعود إلى زمن ملوك فاتحين لدول وبلدان، وسلاطين تعاظم نفوذهم؛ فحصدوا لممالكهم العظمة والسؤود والمجد؛ ويعود إلى التّاريخ الذي كُتب باسم حضارات لا يزال بعضها ينبض بالحياة إلى اليوم؛ ويدخل إلى مكان لا يزال إلى الآن محطّ أنظار العالم؛ فيصبح منتميًا إلى نصّ الرّاوي "يتجاوز بأبعاده الدّلاليّة ما كان قبل الدخول، وهو يشكل داخل الرّواية لونًا إيقاعيًّا متناغمًا مع سائر الألوان الإيقاعية المترتبة على الشخصيات والأحداث"([iv])، وترتبط إليه الرؤية اليوم، برؤية الراوي بوصفه مكانًا مختلفًا عمّا كان عليه في تلك الحقبة؛ المغرقة في البعد، المليئة بالحضارة والثقافة من جهة؛ وبالصراع والقتل من جهة ثانية.في هذا الزمن نادرًا ما يعثر الباحث على أديب، أو مؤلف أو كاتب يرغب في أن يعود بالزّمن إلى الوراء، فما مضى قد ولّى بكل ما فيه، وما الاستمرار والبقاء إلا للمستقبل الذي سيحمل معه كل جديد.لكن حَدَثَ أن غامر محمد بزي، وأمسك بيد الأميرة اليمنية "شمس"، وقد أراد أن يسير إلى جنبها في هذا الزمن "المتوحش"، وأحبَّ أن يعرّفها إلى الحاضر الذي غزته التكنولوجيا قلبًا وعقلًا، وقد تغيَّرَت في ظلها الأعراف والمفاهيم. لكن "ليس كلُّ ما يتمناه المرء يدركه"؛ أحسّت الأميرة بثِقَل قبضته على يدها، ما جعلها تسحبها؛ وراحت تركض أمامه، أرادت أن تسير معه في رحلة عكسية لخطّ سيره، ورغبت في أن يلحق بها إلى زمنها القديم إلى التاريخ الذي أحبته؛ وشغفت به إلى الحضارة التي غارت في الزمن، وما عدنا نسمع عنها شيئًا.تنشأ العلاقة بين الراوي والمرأة من خلال أنثوتها مرّة، ومن خلال فكرها المتوقد مرّة ثانية، فتبرز إلى القارئ من خلال شجاعتها التي فاقت في بعض الأحيان شجاعة الرجال في قيادة المعارك للدفاع عن البلد الذي كان محط أنظار الطامعين، وأخذته على حدّ قوله، إلى "العرب القحطانيين الذين بنوا حضارات وحضارات قبل الإسلام بمئات السنين في الجزيرة العربية"([v]). وقد أرادت أن تعرِّفه إلى واقعها الذي عاشته. فساقنا خلفه إلى هناك، لنقرأ تاريخًا قديمًا برؤية جديدة. إذًا، يحاكي بزي التاريخ القديم، فيستحضر المرأة، وقد كانت لها مكانتها في الحضارة اليمنية القديمة إن على المستوى العسكري أو على المستوى الاجتماعي، فتظهر كشخصية فاعلة مؤثرة في مجتمعها ومع رعيتها التي انقادت لها وأصبحت طوع بنانها يوم دهمت المملكة الخطوب.في الرواية تطالع القارئ ذكريات الأمير "يشجب" مطلة في هذه الرواية من على شرفة العمر، ويرى مملكة "أوسان" وقد عمّرت طويلًا على الرغم من تنافسها مع ممكلة سبأ؛ وقد عانت الكثير بسبب اتساعها، ووفرة خيراتها حيث كانت مطمع الطامعين؛ "فنعرف أنّ القوة والبطش [عاملان] يتحكمان في رقاب... الناس"([vi])، ويتأكد القارئ أن العلاقة بين الأميرة "شمس" ورعيتها علاقة قويّة تقوم على روابط متينة من الودّ والإخاء، وقد انبنت على كثير من المودة والاحترام، إذ لم تكن تلك الملكة المتعجرفة أو المتسلطة، وهذ ما ساعدها في ترسيخ أقدامها في السلطة والحكم.(...)**** باحثة من لبنان - دكتورة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية - الجامعة اللبنانية
[1]- محمد بزي: شاعر، وروائي وصاحب دار نشر، من مدينة بنت جبيل اللبنانية[2]- محمد بزي: شمس أميرة عربية عاشقة، دار الأمير للثقافة والعلوم، بيروت 2017، ط.1. و"شمس" هي أميرة من بلاد اليمن قبل ثلاثة الآف عام قبل الإسلام.[3]- نبيل أيوب: النقد النصي نظريات ومقاربات، دار المكتبة الأهلية، بيروت 2004، ص253[iv]- علي زيتون: في مدار النقد الأدبي، دار الفارابي بيروت 2011، ص67.[v]- محمد بزي: شمس أميرة عربية عاشقة، ص6[vi]- برتراند راسل: الفرد والسلطة، ترجمة د. نوري جعفر، منشورات الجمل، بغداد، 2005م، ص 2005
الحداثة - 197/198 - شتاء 2019 AL- HADATHA - winterISSN: 2790-1785 الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on May 08, 2022 07:09
•
Tags:
alhadatha, مجلة-الحداثة
مجلة الحداثة - Al Hadatha Journal
Al Hadatha Journal - A Refereed Academic Quarterly
مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة
تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)
ISSN/2790 Al Hadatha Journal - A Refereed Academic Quarterly
مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة
تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)
ISSN/2790-1785
تُعنى المجلة بنشر الأبحاث الأكاديمية بعد عرضها على لجنة علمية متخصصة. وتبلورت فكرة نشوء المجلة بعد اجتماعات عمل متواصلة بين رئيس تحريرها فرحان صالح وأصدقاء باحثين وأكاديميين من لبنان والعالم العربي، وقد بات عدد منهم ضمن الهيئة الاستشارية للمجلة، علمًا أن بعضهم قد فارق الحياة، وقد جرى إضافة أسماء إلى الهيئة لاحقًا. تغطي مجلة الحداثة الأبحاث التي تأتي من شريحة واسعة من الأكاديميين والمفكرين والكتّاب والأدباء في لبنان والعالم العربي، فتنشر موضوعات تتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والسياسية، كذلك، موضوعات تتعلق بقضايا فكرية وتراثية وأدبية ونقدية وفنية وإعلامية ...more
مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة
تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)
ISSN/2790 Al Hadatha Journal - A Refereed Academic Quarterly
مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة
تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)
ISSN/2790-1785
تُعنى المجلة بنشر الأبحاث الأكاديمية بعد عرضها على لجنة علمية متخصصة. وتبلورت فكرة نشوء المجلة بعد اجتماعات عمل متواصلة بين رئيس تحريرها فرحان صالح وأصدقاء باحثين وأكاديميين من لبنان والعالم العربي، وقد بات عدد منهم ضمن الهيئة الاستشارية للمجلة، علمًا أن بعضهم قد فارق الحياة، وقد جرى إضافة أسماء إلى الهيئة لاحقًا. تغطي مجلة الحداثة الأبحاث التي تأتي من شريحة واسعة من الأكاديميين والمفكرين والكتّاب والأدباء في لبنان والعالم العربي، فتنشر موضوعات تتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والسياسية، كذلك، موضوعات تتعلق بقضايا فكرية وتراثية وأدبية ونقدية وفنية وإعلامية ...more
- مجلة الحداثة's profile
- 11 followers



