مجلة الحداثة's Blog: مجلة الحداثة - Al Hadatha Journal, page 12
August 14, 2022
المبادئ والأسس اللازمة لقيام البناء الدستوري للدولة في العالم العربي

♦ محمد فياض مشيك *
نبذة عن البحث
تؤدي المبادئ والأسس الدستورية دورًا مهمًا في قيام بناء متين للدولة، على وجه الخصوص في أنظمة الحكم الديمقراطية، حيث تضمّنت غالبية الدساتير هذه المبادئ وأهمّها مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، لكي تتمكّن كلّ سلطة من ممارسة صلاحياتها بشكلٍ شرعيّ. ويبرز في هذا الخصوص دور القضاء الدستوري الحامي للنصوص الدستورية من الانتهاكات التي قد تتعرض لها من قبل السلطة التشريعية.هدفت هذه الدراسة إلى البحث في المبادئ والأسس الدستورية المساهمة في وجود نظام حكم ديمقراطية، إضافةً إلى البحث في بعض القرارات الصادرة عن القضاء الدستوري المتضمّنة لهذه المبادئ والأسس الدستورية. وتتمثّل الأهداف الرئيسة لهذه الدراسة في مناقشة المبادئ والأسس اللازمة لقيام البناء الدستوري المتين في الدولة، حيث بحثنا ذلك من الناحية العملية في الدول العربية على وجه الخصوص، كون غالبية الدول في العالم غير مستقرةّ من الناحية السياسية. عليه إنّ "المبادئ والأسس الدستورية"، من النظريات التي جاءت مخالفة لأذهان غالبية الأنظمة الحاكمة، وهذا ما يبرز أهميّة هذا البحث على المستويين الدستوري والقانوني، إذ تسهم المبادئ والأسس الدستورية في وجود دولة حديثة، تضمن الحقوق والحريات الأساسية، وذلك تماشيًا مع تطور المجتمعات.أما أبرز التوصيات التي قدمتها الدراسة، فهي: إن مفهوم الحكم في العالم العربي تطور على مراحل زمنية مختلفة ومتباعدة، إلاّ أنّ وضع دساتير جديدة في بعض الدول مع وجود تفعيل لدور القضاء الدستوري واحترام المبادئ والأسس الدستورية، قد يؤدي إلى وجود فعالية في عمل المؤسسات الدستورية في الدولة، وبالتالي الانتقال إلى دولة حديثة تكفل الحقوق والحريات الأساسية.الكلمات المفتاحية: دولة، دستور، مبادئ دستورية، مبادئ فوق دستورية***
تأتي تراتبية القواعد القانونية على شكل هرم، ويكون على رأس هذه القواعد الدستور. هذا وفقًا للمبدأ الذي أوضحه الفقيه النمساوي "هانس كلسن" (Hans Kelsen)، حيث يجب أنّ تكون القواعد القانونية متوافقة مع القواعد التي تعلوها درجة. لذا تكون النظريات الدستورية أهم أولويات الباحثين، حيث صبّ الفقهاء السياسيون والدستوريون معظم جهودهم في هذا الخصوص. سابقًا لم تتبلور نظريات الأسس والمبادئ الدستورية بشكل كافٍ، إلاّ أنّ تبلورها الحديث كان مع تطور الفقه القانوني، وتغيّر جذري على صعيد الفكر السياسي في الدول الغربيّة. ومفهومها الحديث بخصوص الدولة لم يكن موجودًا، في ظلّ وجود أنظمة حكم استبدادية تتركّز السلطات فيها بشخص الحاكم، وبطبيعة الحال هذا ما أدّى إلى انتهاكات جسيمة على صعيد حقوق الإنسان. لذا مع تطور النظريات الدستورية، أصبح للأسس والمبادئ الدستورية دورٌ محوريٌ في تثبيت دعائم الدولة الديمقراطية.إنّ المبادئ الدستورية والديمقراطية الحديثة "قد ظهرت إلى الوجود، قبل أنّ تتألف الأنظمة السياسية بوحيها وتأثيرها، إذ إنّ هذه الأنظمة قد تحققت، في الدول الغربية وسائر دول العالم، بفعل هذه المبادئ التي استخرجها الكتّاب في إنكلترا وفي طليعتهم جون لوك (John Locke) في القرن السابع عشر، مع ما تقدمه من التقاليد التحررية في تاريخ بلاده، وعلى الأخصّ فلاسفة القرن الثامن عشر في فرنسا، أمثال مونتسكيو وروسو وفولتير ورجال الانسكلوبديا الشهير".([i]) بطبيعة الحال تبع ذلك رقيّ هذه المجتمعات وتقدمها على غيرها من المجتمعات السياسية المعاصرة، حيث كان للدول الغربية الجزء الأكبر من النقلة النوعية في مجال المبادئ والأسس الدستورية، "تحت تأثير معطاياتها وخصوصياتها".([ii])لقد تطوّرت هذه الأسس بفعل التجارب التي حصلت في الدول الغربيّة، خاصّةً بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكيّة. فكل دولة كان لها دور مميّز على صعيد التجارب الدستوريّة، خاصّةً أنّها جاءت متوافقة مع بيئاتها السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة.يركّز البحث على إشكالية ما إذا كانت المبادئ والأسس الدستورية أصبحت مؤثّرة في بناء الدولة الحديثة في العالم العربي؟ولمعالجة هذه الإشكالية، نلتزم في بحثنا المنهج التحليلي، حيث تمّ استعراض المبادئ الدستورية وتشكّلها التاريخي، والاستناد على قرارات القضاء ذي صلة بالمسألة المطروحة، أو على رأي فقهي قد يسهم في دعم موضوع بحثنا.ساعدت الأسس والمبادئ الدستورية في بناء الدولة الحديثة في الدول الديمقراطية، لذا من أجل الإحاطة بموضوع بحثنا، ارتأينا تقسيم البحث مبحثين:- الأوّل: تطرقنا فيه إلى الأسس الدستورية المساهمة في البناء الدستوري.- الثّاني: المبادئ المساهمة في البناء الدستوري.(...)**** كاتب وباحث لبناني - دكتوراه قانون عام (اختصاص: قانون دستوري) – أستاذ محاضر في الجامعة الإسلامية في لبنان
([i]) أدمون رباط، الوسيط القانون الدستوري العام، دار العلم للملايين، بيروت 1971، الجزء الثاني، ص. 141
([ii]) عصام سليمان، الأنظمة البرلمانيّة بين النظريّة والتطبيق، ط.1، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقيّة، 2010، ص. 12
الحداثة (Al Hadatha) – س. 29 – ع. 224 - صيف 2022 SummerISSN: 2790-1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on August 14, 2022 05:21
أثر جائحة كورونا على مبدأ القوة الملزمة للعقد في ضوء التشريعين اللبناني والفرنسي

♦ نسرين حسين ناصر الدين *
نبذة عن البحث
لا شك في أن جائحة كورونا (COVID-19 pandemic) ألقت بثقلها على مختلف جوانب الحياة الإنسانية، والاجتماعية، والاقتصادية. وبما أن العقد يشكّل محور الأنشطة الاقتصادية وعصبها، فكان لا محال من أن تتأثر هذه العقود بهذه الجائحة لما فرضته من وجوب اتخاذ العديد من التدابير والاجراءات من قبل حكومات الدول بهدف الحدّ من انتشارها. فكان لهذه الاجراءات تأثيرٌ كبيرٌ على العقود وعلى التزامات المتعاقدين، حيث أفرزت آثارًا قانونية ومسّت بقدسية العقود التي لطالما تغنت التشريعات بها في سبيل المحافظة على الاستقرار العقدي، فجعلت من مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، مبدًا مقدسًا وأحاطته بهالة لا يمكن لأحد أن يتجاوزها أو المساس بها سواء من قبل أطرافه أو من قبل القاضي.إلا أن جائحة كورونا أفرزت واقعًا قانونيًّا جديدًا متميزًا بما فرضته من تدابير قيّدت الأفراد والدول على حدّ سواء، حيث كان للإقفال العام والكامل لفترات طويلة، أثرٌ كبيرٌ على جميع المرافق، وكان أشدها تأثرًا التزامات المتعاقدين التي أصبح تنفيذها مستحيلًا، وفي كثير من الأحيان، مرهقًا ومهددًا بالخطر، الأمر الذي يستوجب ضرورة التدخل من قبل القضاء لرفع مخاطر هذه الجائحة التي قد تتداخل أوصافها القانونية. فكان لنا أن نتساءل: ما هو مصير مبدأ القوة الملزمة للعقد في ظل هذه الجائحة؛ أيبقى محتفظًا بقدسيته أم أن هذه الجائحة تلقي بأثرها عليه لتضفي شيئًا من المرونة في تطبيقه؟يعالج هذا الموضوع من خلال مبحثين: الأول، يتعلق بالتكييف القانوني لهذه الجائحة لمعرفة في ما إذا كانت تستجمع شروط كل من القوة القاهرة أو نظرية الظروف الطارئة، ومن ثم البحث في تأثيرها على مبدأ القوة الملزمة للعقد في المبحث الثاني. وذلك في ضوء النصوص القانونية في كل من التشريع اللبناني والفرنسي.- الكلمات المفاتيح: جائحة كورونا، العقد شريعة المتعاقدين، القوة القاهرة، الاستحالة الدائمة، الاستحالة المؤقتة، الظرف الطارئ، وقف تنفيذ العقد***شكلت جائحة كورونا فاجعة صحيّة واقتصادية عجزت أقوى دول العالم عن مواجهتها، حيث إنه بفعل هذه الجائحة أصبحت دول العالم معزولة عن بعضها البعض بفعل الإجراءات الاحترازية الصارمة التي اتخذت للحدّ من تفشي هذا الوباء ومحاولة احتوائه. ولم يكن لبنان بعيدًا من ذلك، حيث اتخذت الحكومة اللبنانية العديد من التدابير من فرض حظر للتجول إما بشكل كلّي أو جزئي، وإلى إقفال للحدود والمعابر البرية، وتوقيف لحركة الملاحة الجوية والبحرية، كل ذلك كان بهدف الخروج من هذه الأزمة بأقل خسائر ممكنة.وإذا كان من شأن تفشي هذا الوباء أن أثّر على اقتصاديات العالم أجمع، فمن الطبيعي أن يؤثر بشكل قوي على اقتصاديات أي عقد وعلى قدرة المتعاقدين في تنفيذ عقودهم.ولما كانت العقود تسهم في تنظيم العلاقات بين البشر في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية، إلا أن حدوث أمور استثنائية كالزلازل والفيضانات والحروب والأوبئة من شأنه أن يؤثر على هذه العقود، ويحول دون تنفيذها أو يجعل تنفيذها مرهقًا، ولعل من أبرز هذه الحوادث الاستثنائية ما نعايشه اليوم من انتشار لفيروس كورونا التي اجتاحت العالم وألقت بثقلها على مختلف جوانب الحياة ومنها الجانب القانوني بعد اتخاذ الحكومات للعديد من الإجراءات الاحترازية بهدف حماية الصحة العامة للأفراد، ما أدى إلى إيقاف الكثير من الأنشطة الاقتصادية، مما أثر وبشكل كبير على اقتصاديات العقود وعلى التزامات الأفراد.إن مواجهة هذه الجائحة باعتبارها حدثًا استثنائيًّا لا يمكن توقعه ولا يمكن دفعه، يتطلب منّا البحث عن حلول قانونية تساعد في وضع حدّ لآثارها السلبية على المتعاقدين الذين أصبحوا في حالة عجز عن تنفيذ التزاماتهم.وإذا كان المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه العقود كافة هو أن العقد شريعة المتعاقدين، على اعتبار أن المتعاقد عندما تتجه إرادته لإبرام العقد إنما اتجهت إلى الالتزام بكل ما ينتج عنه من التزامات عملًا بمبدأ القوة الملزمة للعقد الذي يفرض على أطراف العقد الالتزام بمضمون العقد وتنفيذه، وبالتالي لا يستطيع أي طرف فيه أن يتحلل منه بإرادته المنفردة من دون موافقة الطرف الآخر، وإلا كان من شأن عدم التزامه بالعقد أن يرتب المسؤولية عليه.إن أهمية هذا المبدأ تنبع من كونه يساهم في استقرار المعاملات، ويشكل ضمانة مهمة لتنفيذه وتحقيق الفائدة الاقتصادية المرجوة منه على اعتبار أن مبدأ القوة الملزمة للعقد يشكل القلعة الحصينة لمبدأ سلطان الإرادة على حدّ تعبير الفقيه الفرنسي جون كار بونييه (John Carbineer)، إلا أن مواجهة الحوادث الاستثنائية التي قد تحدث أثناء تنفيذه ومنها جائحة كورونا، يجعل من الأخذ به على إطلاقه أمرًا مجحفًا بحقّ المتعاقدين الذين أصبحت مصالحهم مهددة بالخطر نتيجة عدم تمكنهم من الوفاء ببعض أو كافة التزاماتهم التعاقدية ما يدفعهم إلى البحث عن أي وسيلة تمكنهم من طلب الاعفاء من تنفيذها مؤقتًا أو دائمًا.في هذا الإطار بات من الضروري البحث عن وسائل قانونية يمكن للمتعاقدين اللجوء إليها لدفع المخاطر التي قد تلحق بهم نتيجة هذه الجائحة.من هنا، كان لا بدّ من العودة إلى ما تبناه الفقه القانوني والاجتهاد القضائي لمواجهة مثل هذه الحوادث الاستثنائية، حيث تبنى هذان الأخيران وسيلتين قانونيتين هما: القوة القاهرة والظروف الاستثنائية. الأولى منهما ترمي إلى مواجهة الحالات التي يصبح فيها الالتزام العقدي مستحيل التنفيذ، والأخرى ترمي إلى مواجهة الحالات التي لا يصبح فيها الالتزام مستحيل التنفيذ إنما مرهقٌ للمدين. إلا أن الوسيلتين وإن تشابهتا في الشروط الواجب توافرها، إلا أنهما تختلفان في آثارهما على العقد. كما أن سلطة القاضي تختلف بحسب تكييفه للحادث الاستثنائي في ما إذا اعتبره قوة قاهرة أم ظرفًا طارئًا.
- أهمية الدراسةتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تسلط الضوء على جائحة انتشرت في كل أنحاء العالم ومعرفة آثارها على مبدأ أساسي يقوم عليه العقد ألا وهو مبدأ القوة الملزمة للعقد. بالإضافة إلى تحديد التكييف القانوني لهذه الجائحة، وتبيان الوسائل القانونية المتاحة لمواجهتها. وذلك من أجل إحاطة هذه الجائحة بعدد من الدراسات نظرًا إلى حداثتها وآثارها التي امتدت لتشمل الميادين كافة.
- أهداف الدراسة:تتجلّى أهداف الدراسة في:- تحديد قدرة البيئة القانونية في لبنان على تشخيص جائحة كورونا من خلال استقراء النصوص القانونية التشريعية والقانونية لأجل استخلاص بعض الحلول المناسبة للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الجائحة على التزامات المتعاقدين.- تحديد الطبيعة القانونية للجائحة في ضوء النظريات القانونية.- تحديد السلطات التي يتمتع بها القاضي في مواجهة آثار هذه الجائحة.
- مشكلة الدراسةتتمحور إشكالية البحث حول ما هو مصير مبدأ القوة الملزمة للعقد في ظل جائحة كورونا؟ويتفرع منها عدة تساؤلات:- هل تشكل هذه الجائحة استثناءً أم خروجًا على مبدأ القوة الملزمة للعقد؟- ما هي الطبيعة القانونية لجائحة كورونا؟- ما هو مصير الالتزام العقدي في ظل هذه الجائحة؛ هل يبقى المتعاقد ملزمًا في تنفيذ العقد الذي أبرمه أم أن ذلك أصبح دربًا من دروب الخيال لخروج هذا الأمر عن إرادته؟- هل يمكن تطويع القواعد العامة في قانون الموجبات والعقود اللبناني لأجل الوصول إلى حلول تمكن القاضي من التعامل مع هذه الجائحة لحماية المتعاقدين؟ وما هي سلطة القاضي في هذا الإطار؟(...)**** باحثة لبنانية – أستاذة في كلية الحقوق- قسم القانون الخاص - الجامعة الإسلامية في لبنان
[1] عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط. 3، 1998، ص 120
[2] المادة 221 من قانون الموجبات والعقود اللبناني: "إن العقود المنشأة على وجه قانوني تلزم المتعاقدين، ويجب أن تفهم وتفسر وتنفذ وفاقًا لحسن النية والانصاف والعرف".ARTICLE 1134 du Code civil français: Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
[3] Gabriel Marty, Pierre Raynaud, droit civil, les obligations tome I,2eme edition, 1998, Sirey, p:41
الحداثة (Al Hadatha) – س. 29 – ع. 224 - صيف 2022 SummerISSN: 2790-1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on August 14, 2022 00:46
أملاك الرهبانيات في المعلقة - أساليب التملك والاستثمار من خلال 7 وثائق تاريخية

♦ عماد أنيس البعقليني *
نبذة عن البحث
يعالج هذا البحث، عبر سبع وثائق تاريخية، أملاك الرهبانيات في بلدة المعلقة البقاعية (لبنان)، مبرزًا أساليب التملك والاستثمار التي اتبعها مسيحيو لبنان في عهد الأمير بشير الشهابي (1767 – 1850م). ويلقي البحث الضوء على أهم الرهبانيات في المعلقة، وكيفية تملكها، موضحًا أساليب الاستثمار المتبعة في إدارة أملاك الرهبانيات وفق القوانين العثمانية وتعديلاتها، وفي الختام صور عن الوثائق السبع.الكلمات المفاتيح: أملاك الرهبانيات، المعلقة، تملك، وثائق***1- مدخل: أسباب اختيار الرهبانيات للمعلقةيعود تاريخ ظهور بلدة المعلقة إلى مرحلة حكم الشهابيّين، حين بناها الأمير بشير الشهابي في العام 1814م، إذْ شرع بنقل أبنية الكرك إلى محلّتها لتثبيت حكمه في حاضرته الجديدة المعلقة. وقد أصبحت نافذته على البقاع الخصيب ومستودع الغلال، فباشر ببناء السّراي فيها، وعيّن ابنه خليلًا حاكمًا على زحلة والبقاع الجنوبي، وجعل الأخير من المعلقة مقرًّا له([i]).نمت المعلقة فكريَّا واقتصاديًّا خلال العهد الشهابي، فالأمير بشير وأفراد من عائلته قدموا الهبات للكنائس والأديرة والرهبانيات، وهذا ما أدّى دورًا أساسيًّا في زيادة أعدادها على أراضيها، فعلى سبيل المثال لا الحصر: الهبة المقدمة من الأمير بشير للرهبنة المخلصية في المعلقة.([ii])
2- أهم الرهبانيات في المعلقة
تضمّ المعلقة نموذجًا فريدًا من المذاهب المسيحية والرهبانيات، فقد تمركزت فيها الرهبنة اليسوعية، والرهبنة المخلصية، والرهبنة الشويرية، والرهبنة المارونية، والطائفة الأرثوذكسية، وكان لكلٍّ منها، مراكز وأديرة وكنائس ومدارس، إضافةً إلى تملكها العديد من الأراضي والمغالق.(...)**** باحث لبناني – يعدّ أطروحة دكتوراه في التاريخ - المعهد العالي للدكتوراه – الجامعة اللبنانية
[i]- مهيب حمادة: تاريخ علاقة البقاعيين بالسوريين واستراتيجية البقاع في المواجهة السورية الإسرائيلية، لا.د.، الجزء الأول 1918 – 1936، ص 19
[ii]- راجع الوثيقة رقم (1)
الحداثة (Al Hadatha) – س. 29 – ع. 224 - صيف 2022 SummerISSN: 2790-1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on August 14, 2022 00:36
الكلب عند العرب بين المدح والذّمّ

♦ مدلان حبيب حبيب *
نبذة عن البحث
ارتبط الإنسان بالحيوان منذ الخليقة، وقصّة تمثُّل الشّيطان بصورة الحيّة لحوّاء، وإغراؤها بالأكل من الشّجرة الّتي حرّم اللّه من الأكل منها معروفة.([1])كانت علاقة الإنسان بالحيوان أحاديّة عدائيّة قبل تدجينه، إذ كان يقتله إمّا لدرْء خطر، وإمّا للاستفادة من لحمه وجلده؛ ثمّ ما لبثت أن أصبحت ثُنائيّة؛ وذلك بعد تدجين بعض أصنافه، فاستغلّها في طعامه (لحم، حليب، بيض...)؛ لِصنع ثيابه وأثاث منزله (صوف، شعر، وبر، جلد، ريش)، ولتنقّلاته ونقل أثقاله، كذلك في حراسة منزله وحيواناته، وحِراثة أرضه، وتنزّهه، ولهوه، ورياضته، وتنظيف بيته من الفئران والجرذان.وكان للعرب، كسائر شعوب الأرض، هذه العلاقة المزدوجة مع الحيوان. وقد برز من بين الحيوانات الأليفة الّتي ربّوها ثلاثة: الجمل، والحصان، والكلب. أمّا الأوّل، فقد مَلَأ لغته، وأمثاله، وأشعاره، وحياته، إذ كان عونه في حِلّه وترحاله، ويأكل من لبنه ولحمه، ويتّخذ من وبره بيته وغطاءه، ومن جلده نعله وأدواته. أمّا الحصان، فقد كان له مكانة خاصّة عند فرسان العرب، يهتمّون به أشدّ الاهتمام؛ لأنّه عليه يغير على أعدائه، وينجو منهم، إذا دارت الدّائرة عليه؛ وأمّا الكلب، فقد استخدموه في حراسة بيوتهم وماشيتهم من اللّصوص والوحوش، وفي الصّيد، وجَلْب الضّيوف عن طريق استنباحه.- تسويغ البحث وإشكاليّتهالحيوان عند العرب إمّا محبوب ممدوح كالجمل، والحصان، والأسد، وإمّا مكروه مَذموم كالذئب والضّبع والخنزير، لكنّ الكلب([ii]) ينفرد بين سائر الحيوانات عند العرب في أنّه ممدوح مذموم في الوقت نفسه. وقد جاء في مدح الكلاب في كتاب "الحيوان للجاحظ" (255ه/ 869م):"فإذا حكينا قول من عدّد محاسنها، وصنّف مناقبها، وأخذنا من ذِكْر أسمائها وأنسابها وأعراقها، ومن تفدية الرّجال إيّاها، واستهتارهم بها، وذكر كسْبها وحراستها، ووفائها وإلْفها وجميع منافعها، والمرافق الّتي فيها، وما أُودِعت من المعرفة الصّحيحة، والفِطَن العجيبة، والحسِّ اللّطيف، والأدب المحمود. وذلك سِوى صِدق الاسترواح، وجَودَةِ الشّمِّ، وذِكْر حفظها ونفَاذها واهتدائها، وإثباتها لصُوَر أربابها وجيرانها، وصبرِها، ومعرفتِها بحقوق الكرام، وإهانتها اللّئام، وذكر صبْرها على الجفا، واحتمالها للجوع، وذكر ذِمامها، وشدَّةِ مَنْعِها مَعَاقِد الذِّمَارِ([iii]) منها، وذكر يَقَظَتها، وقِلَّة غفلتها، وبُعْدِ أصواتها، وكثرة نسْلها، وسرعة قَبولها وإلقاحها وتصرُّفِ أرحامها في ذلك، مع اختلاف طبائع ذكورها والذّكور من غير جنسها، وكثرة أعمامها وأخوالها، وتردُّدها في أصناف السِّباع، وسلامتها من أعراق البهائم، وذِكْر لَقَنها وحكايتها، وجودة ثقافتها([iv]) ومَهْنِها وخِدمتها، وجِدِّها ولِعْبها وجميع أمورها؛ بالأشعار المشهورة، والأحاديث المأثورة، وبالكتُبِ المنَزَّلة، والأمثال السّائرة، وعن تجرِبةِ النّاس لها، وفِراستِهم فيها، وما عايَنوا منها؛ وكيف قال أصحاب الفأل فيها، وبإخبار المتطيِّرين عنها".([v])ووضع أبو بكر محمّد بن خلف المرزبانيّ (309ه/ 921م) كتابًا بعنوان "تفضيل الكلاب على كثير ممَّن لبس الثّياب"، جاء فيه أنّه "يُروى عن الحسن البصري أنّه قال: في الكلب عشر خصال محمودة، وكذلك ينبغى أن تكون في كلّ مؤمن:- الأولى: أنّه لا يزال خائفًا... وذلك من دأب الصّالحين.- والثّانيّة: أنّه ليس له مكان يعرف... وذلك من علامات المتوكّلين.- والثّالثة: أنّه لا ينام من اللّيل إلّا قليلًا. وذلك من صفات المحسنين.- والرّابعة: أنّه إذا مات، لا يكون له ميراث... وذلك من أخلاق الزّاهدين.- والخامسة: أنّه لا يترك صاحبه، ولو جفاه وضربه... وذلك من صفات المريدين.- والسّادسة: أنّه يرضى من الدّنيا بأدنى مكان... وذلك من علامات المتواضعين.- والسّابعة: أنّه إذا طرده أحد من مكان وانصرف عنه، عاد إليه... وذلك من صفات الرّاضين.- والثّامنة: أنّه إذا ضُرب وطُرد ثمّ دُعي، أجاب بلا حقد... وذلك من صفات الخاضعين.- والتّاسعة: أنّه إذا حضر شيء للأكل، جلس من بعيد... وذلك من صفات المساكين.- والعاشرة: أنّه إذا حضر رجل من مكان لا يرحل معه شيء يلتفت إليه... وذلك من صفات المتجرّدين".([vi])
وقيل في ذمّها "وتعداد أصناف معايبها ومثالبها؛ مِن لؤمها وجبنها، وضعفها وشرَهها، وغدْرِها وبَذَائها، وجهْلها وتسرُّعها، ونتْنها وقذَرها، وما جاء في الآثار من النَّهْي عنِ اتّخاذها وإمساكها، ومن الأمْر بقتْلِها وطردها، ومن كثرة جناياتها وقلَّة رَدّها،([vii]) ومن ضرب المثل بلؤمها ونذالتها، وقبحِها وقبْح معاظلتِها،([viii]) ومِن سماجة نُباحِها، وكثرة أذاها، وتقذُّر المسلمين من دنوِّها، وَأنّها تأكل لحومَ النّاسِ، وأنّها كالخلْق المركّبِ والحيوان الملفّق: كالبغل في الدّوابِّ، وكالراعِبيِّ في الحمام، وأنّها لا سبعٌ ولا بهيمة، ولا إنسيَّةٌ ولا جِنِّيَّة، وأنّها من الحِنِّ([ix]) دون الجِنّ، وأنّها مطايا الجِنِّ ونوعٌ من المِسْخ، وأنَّها تنبُش القبور، وتأكل الموتى، وأنّها يعتريها الكَلَبُ مِن أكل لحوم النّاس".([x])وقيل: "وما بلَغ من قدر الكلب مع لؤم أصله، وخُبث طبعه، وسقوط قدره، ومهانة نفسه، ومع قلَّة خيره، وكثرة شرّه، واجتماع الأمم كلِّها على استسقاطه، واستسفاله، ومع ضربهم المثل في ذلك كلِّه به، ومع حاله الّتي يعرف بها، من العجز عنْ صولة السِّباع واقتدارها... ولأنّ الكلب ليس بسبع تامّ، ولا بهيمة تامّة، حتّى كأنّه من الخلْق المركّب والطّبائع الملفّقة، والأخلاط المجتلبة، كالبغل المتلوِّن في أخلاقه، الكثير العيوب المتولّدة عن مزاجه".([xi])فلماذا كان الكلب ممدوحًا مذمومًا في الوقت نفسه؟ وما هي الصّفات الّتي ذمّت فيه، أو الّتي مُدحت فيه؟ وهل كان العرب على حقّ في ما وصفوه من صفاته، وفي آرائهم فيه؟ هذا ما أحاول معالجته في هذا البحث.(...)***
* باحثة لبنانية - تعدّ أطروحة دكتوراه في اللغة العربية وآدابها في جامعة الجنان (لبنان)
[1]- انظر: الإصحاح الثّالث من سفر التّكوين من الكتاب المقدّس
[2]- الكلب حيوان ثدييّ لاحم، جمجمته مستطيلة، في فمه 42 سنًّا لتمزيق اللَّحم. يتميّز بسرعة العدو، وبحاسّتي الشَّمّ والسّمع. والكلاب أنواع عديدة، تختلف في ما بينها بالحجم، والوزن، واللّون، والعمر، وغير ذلك.والكلب المنزليّ أو كلب الحراسة، أو كلب الرّعي دُجِّن قبل خمسة عشر ألف سنة، ومنه أكثر من ثمانين سلالة، طوله بين 120 و150 سنتم، ووزنه بين 20 و40 كلغ. له عضلات قويّة تجعله قادرًا على الوثْب الطّويل. عيناه صغيرتان على جانبيْ رأسه، يستطيع بهما الرّؤية على مسافة بعيدة. تتزاوج أنثاه مع عدّة ذكور، وتحمل مدّة تتراوح من 63 إلى 67 يومًا، وتضع بين 5 إلى 6 جِرار. عمره بين 14 و18 سنة.
انظر: موسوعة المورد العربية 974/2؛ والموسوعة العمانية 8/2993؛ 2/293 univers des animaux
[3]- الذّمار: ما يلزمك حفظه وحمايته
[4] - الثقافة: الحذق والفطنة
[5]- الحيوان 1/ 222- 223
[6]- تفضيل الكلاب عن كثير ممّن لبس الثّياب، ص 103- 104
[7]- الرد: النّفع
[8]- العظال: الملازمة في السفاد من الكلب ونحوه
[9]- الحِنّ: سَفلة الجنّ وضعفاؤهم (المعجم الكبير مادة حنن)
[10]- الحيوان 1/102.
[11]- الحيوان 1/102.
الحداثة (Al Hadatha) – س. 29 – ع. 224 - صيف 2022 SummerISSN: 2790-1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on August 14, 2022 00:26
واقع العطّارين ودورهم في مصر القرن التاسع الهجري (خامس عشر ميلادي)

♦ عماد حنّا القليطي *
نبذة عن البحث
تهدف هذه الدراسة إلى معالجة جوانب من واقع فئة من كبار التجّار في مصر الذين أدّوا دورًا متميزًا، وتخصصوا بتجارة التوابل خلال العصر المملوكي في القرن التاسع الهجري (الخامس عشر الميلادي). وهذه الفئة عُرفت باسم: "العطارين"، وقد ساهمت إلى حدٍّ كبير، في تنشيط الحياة الاقتصادية في الدولة المملوكية.تركز هذه الدراسة على أماكن تواجد هؤلاء التجّار وإقامتهم، بالإضافة إلى مؤهلاتهم العلمية وعلاقاتهم مع الأوساط الحاكمة من جهة، ومع باقي التجّار من جهة أخرى من حيث الروابط والعلاقات الزوجية أو التجارية. كما تعالج الدراسة معلومات عن وضع هؤلاء التجّار الاجتماعي كثرواتهم والغنى الذي تمتعوا به، بالإضافة إلى الأعمال الخيرية والإحسان.- الكلمات المفاتيح: عطّارون، مصر، عصر مملوكي، تجارة إسلامية***احتلّت مصر في العصر المملوكي (1250 – 1517م)، ولا سيما في القرن التاسع الهجري (خامس عشر ميلادي) مكانة مهمّة في التجارة العالمية؛ فبسبب موقعها وصلت التجارة فيها إلى أعلى مستوياتها، وكان القسم الأكبر من البضائع الشرقية التي كانت تصل إلى أوروبا عبر البحر المتوسط وقبل اكتشاف الطريق البحرية إلى الهند عبر رأس الرجاء الصالح العام 1498م، يُشحن من موانئ مصر وبلاد الشام. كما عُدّ هذا القرن بيئة حاضنة للتجّار الذين كانوا منظّمين بشكل كبير.تعالج هذه الدراسة مسألة مهمّة في تاريخ السلطنة المملوكيّة تتمثل بالدور الذي ساهم به كبار التجّار في مصر خلال القرن التاسع الهجري (خامس عشر ميلادي). فالمسألة المطروحة تتمثّل في رسم الإطار الذي تشكّلت ضمنه فئة معينّة من هذه الطبقة وهي: "العطّارون" وصعودها الاجتماعي والاقتصادي، مع تحديد توسّعها ونفوذها وإظهار هويّة "كبار التجّار" في مصر ودورهم. إذ شكل كبار التجّار خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين (الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين) حركة ناشطة في العصر المملوكي كانت أهم منابع الثروة في مصر. وبخصوص فئة "التجّار العطّارين"، واستنادًا ﺇلى كتب التراجم، كان هناك ثلاثة أنواع من التجّار ضمن هذه الفئة: "عطّار" للدلالة على تاجر الكارم،1 و"عطّار" يتاجر بالعطور، وأخيرًا "عطّار" يتاجر ببيع الأعشاب.
- التجّار في المجتمع المملوكي
يشكّل التجّار عنصرًا أساسيًّا في المجتمع المملوكي في القرن التاسع الهجري (خامس عشر ميلادي)، تعادل بأهميّتها الجيش والإدارييّن ورجال الدين. لكن، تبقى هناك مزايا خاصّة ومهمّة تتعلّق بالأصول الاجتماعيّة للتجّار على الرغم من المعلومات النادرة حول وضعهم الاجتماعي، وطريقة عيشهم وانخراطهم في المجتمع وتحصليهم العلمي وعلاقاتهم مع أطياف المجتمع والآخرين. ومن خلال المصادر التاريخية، نستنتج أنّ بيئة التجّار لم تكن متجانسة، إذ أمكننا التمييز بين عدّة فئات من التجّار؛ فالمجتمع لم يعرف نظامًا خاصًّا ومحدّدًا بالتجّار.إنّ أبرز كتّاب ذلك العصر كالسخاوي (توفي العام 902ه/1497م)،2 وابن حجر العسقلاني (852ه/1449م)3، والمقريزي (845ه/1442م)4 وغيرهم، قد استعملوا تعابير مختلفة للدلالة على التجّار مثل: "تاجر"، "تاجر كبير"، "كبير التجار"، "رئيس التجّار"، "تاجر خواجة"، "الكارم"، "العطّارون"،...وبما أنّ دراستنا هذه ترتكز على فئة معيّنة من التجّار، وهم كبار التجّار وتحديدًا فئة "العطّارين"، كان من الضروري إيجاد معايير للتمييز بينهم وبين باقي التجّار. من هنا ضرورة الاعتماد على المصطلحات التي استعملت في كتب التراجم مثل: "تاجر" و"خواجة" و"كبير التجّار" وغيرها، بالإضافة ﺇلى مجموعة من المؤثّرات التي قد تدلّ بشكل كبير على فئة كبار التجّار وهي: الغنى، والمنازل، والرحلات التجارية، والأماكن.تدلّ كلمة تاجر على تاجر كبير يتميّز عن التاجر "المتسبّب" الذي يملك محلًا في السوق. واستنادًا ﺇلى المعطيات في كتب التراجم، نستنتج أنّ كبار التجّار هم الذين يمارسون التجارة الطويلة المسافات ويجلبون بضائع نادرة وفخمة. ﺇنّه تاجر سفر، يتمتّع بثروة كبيرة وعلاقات قويّة مع الجيش والسلطات الدينيّة (ابن خلدون، 2000، ص 294- 295). فهؤلاء التجّار ليسوا متخصّصين، بل يتاجرون بكل شيء، وهذا الذي يميّزهم عن أصحاب المحال في السوق. (Rosenberger,2, 2000, 249)إذًا، شكّل كبار التجّار خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين (الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين) حركة ناشطة جدًا في العصر المملوكي كانت أهم منابع الثروة في مصر.(...)***
* باحث لبناني - يعدّ أطروحة دكتوراه في التاريخ في المعهد العالي للدكتوراه - الجامعة اللبنانية
1. إنّ مصطلح "الكارميّة" و"تجّار الكارم"، هو اسم أطلق على طائفة من كبار التجّار كانوا يحتكرون تجارة التوابل والبهار ما بين مصر واليمن من جهة، وجنوبي شبه الجزيرة العربيّة والهند والشرق الأقصى من جهة أخرى. (حلّاق، وصبّاغ، 1999، ص. 184؛Vallet, 2010, 505-540)2. شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخّاوي – نسبة الى سخا شمال مصر- الشافعي (831هـ ـ 902هـ /1428م- 1496م): هو مؤرخ وعالم حديث وتفسير، أديب من أعلام مؤرخي عصر المماليك. ولد وعاش ومات في القاهرة. صنّف أكثر من مائتي كتاب (السخّاوي، 3، 8، 2003– 25 رقم1041)3. هو شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن حجر بن أحمد العسقلاني الكناني، الكناني القبيلة العسقلاني الأصل الشافعي المذهب المصري المولد (773–852هـ/ 1372–1449م) الملقب "بأمير المؤمنين في الحديث". توفي والده وهو صغير فكفله أحد أقارب والده زكي الدين الخروب كبير تجّار الكارم في مصر فرعاه الرعاية الكاملة. حفظ القرآن الكريم وهو صغير، قام بعدة رحلات في طلب العلم إلى مكّة والحجاز واليمن وبلاد الشام وأقام في فلسطين. شغل الكثير من الوظائف المهمّة في الإدارة المملوكية المصرية. له مؤلفات وتصنيف كثيرة زادت على مئة وخمسين مصنفًا في مجموعة من العلوم. توفي سنة 852هـ/1449م. (السخاوي، 2003، 2، 33–36 رقم 986)4. هو أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم بن محمّد بن تميم بن عبد الصمد بن أبي الحسن بن عبد الصمد بن تميم التقي أبو العباس بن العلاء بن المحيوي الحسيني العبيدي ويعرف بابن المقريزي وهي نسبة لحارة في بعلبك تعرف بحارة المبارزة. ولد في القاهرة ونشأ فيها وحفظ القرآن الكريم. دخل دمشق واستلم فيها وظائف، ثم عاد الى بلده واشتغل بالتاريخ حتى اشتهر به. له العديد من المؤلفات زادت عن المئة. توفي في القاهرة سنة 845ه/1441م (السخاوي، 2003، 2، 20–23 رقم 948)5. اعتمد السلطان برسباي كالعديد من سلاطين المماليك، سياسة اقتصادية تقوم على احتكار التوابل، والسكّر بالإضافة إلى الأقمشة، وكانت عمليات الشراء بالإكراه لمقادير معيّنة من المواد بسعر تحدّده الحكومة، وبسبب هذه السياسة، لحقت الخسائر بكبار التجّار في مصر وبلاد الشام، بعضهم أفلس وخسر ثروته، والبعض الآخر تحوّلوا إلى عملاء وتجّار لصالح السلطان. لمزيد من المعلومات عن سياسة السلطان برسباي (راجع: Ashtor, 1974-1979, 551-572 Darrag 1961, 73-107; Appellaniz, 2009, 57-59)6. الخانقاه: مكان ينقطع فيه المتصوّف للعبادة، وهي تجمع بين تخطيط المسجد والمدرسة بالإضافة إلى غرف للعبادة. فهو إذًا رباط الصوفيّة ومكان عبادتهم وتجمّعهم. (حلاق، وصبّاغ، 1999، .80؛Encyclopédie de l’Islam, 1978, IV, 1057-1058)7. المذهب الحنفي: أحد أهم المذاهب الفقهية أسّسه النعمان بن ثابت وكنيته أبو حنيفة (توفي سنة 150هـ/767م)، والأصول التي اعتمد عليها الإمام في الاجتهاد والفقه هي: القرآن الكريم، وسنّة النبي، وقول الصحابة والاجتهاد، انتشر هذا المذهب في بلاد المشرق والمغرب ومصر. زها أبو حنيفة في الكوفة وبغداد.المذهب المالكي: المؤسس الإمام مالك بن أنس (توفي سنة 179هـ/795م). نشأ هذا المذهب في المدينة المنوّرة، ويعدّ أحد أكثر مذاهب الشرع الإسلامي وأوسعها وأكثرها تساهلًا.المذهب الشافعي: أسّسه الإمام محمد بن إدريس الشافعي (توفي سنة 204هـ/820م) الداعي إلى سبيل الاعتدال وبلزوم القياس مع بعض التحفظ.المذهب الحنبلي: ينسب إلى الإمام أحمد بن حنبل (توفي سنة 241هـ /855م) تلميذ الإمام الشافعي وأحد أصحاب الحديث المتشدّدين. (حتّي، 1944، 469–472)8. المارستان أو بيمارستان: مصطلح يطلق للدلالة على المصح والمستشفى (حلاق، وصبّاغ، 1999، 49)
الحداثة (Al Hadatha) – س. 29 – ع. 224 - صيف 2022 SummerISSN: 2790-1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on August 14, 2022 00:17
من الصدام إلى الاستلاب رحلة المجتمعات العصبانية في أوطان مهدورة - بحث في المصطلحات التي تترافق مع مفهوم العصبية

♦ منال محمود مكداش *
نبذة عن البحث
يعدّ مفهوم "العصبية" بمضامينه الشائكة من المفاهيم التي عادت للظهور مجددًا في العصر الحديث، وأصبح الحديث عنها مقبولًا خاصّة بعد مرحلة الثورات العربية، وما رافقها من انتكاسات على الصعيدين المجتمعي والسياسي، مما جعل الصراع العصباني يعود إلى الواجهة في العمل السياسي وفي السلوكيات المجتمعية.لم يعد ممكنًا اليوم تجاهل مصطلح العصبية بعد أن أثبتت وجودها الحيّ في أكثر المجتمعات العربيّة، مؤكّدة تحكّمها بمجمل الأفكار والمسالك التي تستقبلها العصب[1] من العالم الخارجي، فتقوم بقبولها ورفضها وفقًا لمصلحتها الخاصّة (معتوق، 2017، ص10-11) دون أن يكون للفرد؛ كفرد حرّ أيّ قرار في هذه العمليّة. يرفض الكثير من المفكّرين الخوض في موضوع العصبية والتنظير له بحسبان أنّه موضوع تجاوزته المجتمعات الجديدة خاصة بعد قيام الدول على الشكل الحديث. كما أنّ بعضهم يرفض الحديث فيه لأنه موضوع دقيق نظرًا إلى ارتباطه المباشر بالدين. ومع ذلك، فإنّ هذه الظاهرة تستحقّ التوقّف عندها ودراستها خاصّة أنّ المتتبّع لحالة المجتمعات العربيّة اليوم، والمراقب لحركة العمليّة السياسيّة في أكثر الدول يجد أنّ مجتمعاتها ما زالت تقوم على العصبية والتعصب، وهي تفرض سلوكًا محدّدًا في علاقة الجماعات المكوّنة للشعب الواحد مع بعضها البعض، وأكثر ما يميّز هذا السلوك هو صورته النمطية الثابتة التي لم تتغيّر رغم خضوعه لعدّة تطورات تاريخية واجتماعية وثقافية وغيرها.يهتمّ البحث بدراسة حركة العصبية في المجتمعات العربية، وتتبع تمظهراتها ونتائجها على الأوطان والمجتمعات منطلقًا من ثلاثة عناوين أساسيّة لكتابين وعنوان يشكّل جزءًا من عمل مشترك، إذ إنّ معرفة الواقع هي أساس أي عمليّة تغييريّة قد تسهم في التحول إلى المجتمعات التقليدية العربيّة إلى مجتمعات ديمقراطية.الكلمات المفتاحيّة: العصبية، الصراع، آكلة، هدر، استلاب، الإنسان، الأوطان***
يثير مصطلح "العصبية" في ذهن القارئ أو المستمع صورًا نمطيّة سلبية على الرغم من أنّ المفهوم بحدّ ذاته، لا يحمل هذا المعنى، فالعصبية كما كانت تُفهم سابقًا هي رابطة تربط الناس ببعضهم البعض على أساس الدم والقربى أو حتّى الحلف، وقد اقتضتها ضروريّات الحياة من تأمين الطعام والدفاع عن النفس. (ابن خلدون، د. ت، ص27) أمّا اليوم فينظر إليها وخاصّة في الميدان السياسي على أنّها مفهوم تقليدي له مضامين سلبية يجب تجاوزها لتحقيق اندماج حقيقي بين مجموعات الشعب الواحد، فالعصبية من العوائق التي تقف حاجزًا أمام بناء هويّة كلّيّة جامعة للعصب المتفرّقة المكوّنة للشعب والذين يتشاركون مع بعضهم البعض الأرض أو ما يعرف بالوطن.لا تعدّ العصبية غاية أو هدفًا، إنّما هي آليّة حركيّة طيّعة قابلة لأن تأخذ من حيث الشكل ما يناسبها للمحافظة على بقائها من دون أن يمسّ ذلك بنيتها الداخلية، وهي تتحكّم بسلوك أفراد عصبتها، تحكمًا كاملًا يحقّق لها الهدف الأساسي من بقائها حيّة وهو الحفاظ على وجود العصبة ومصالحها والدفاع عنها وحمايتها من أي خطر قد يهدّد وجودها. وتشير العديد من الدراسات الحديثة ومنها دراسة "لعلي وطفة" نشرت في كتاب: الهوية وقضاياها في الوعي العربي المعاصر (2013)، أنّ مشاعر الانتماء الطائفي والقبلي تسيطر على المجتمعات العربيّة وتقودها لتعيش حالة من التعصب والتمييز الطائفي والعشائري والعرقي، وهذا يؤكّد أنّ العصبية كمفهوم قديم ما زالت حيّة في هذه المجتمعات، وكأنّ الزمن لم يمرّ عليها، وكأن المجتمعات العربيّة لم تتجاوزها، خاصة أنّها (العصبيّة) استطاعت انتاج ذاتها من جديد بعد انتهاء مرحلة الثورات العربيّة أو ما عرف بـ"الربيع العربي"، وبدأت بالتحكّم بالمجتمعات العربيّة، ففتكت بالدولة وبمؤسساتها عبر هدر كلّ طاقات الوطن، وهدر طاقات الإنسان الفاعل في هذا الوطن ما أدّى إلى توقّف عمليّة بناء الدولة الحديثة القائمة على المواطنة وقبول الآخر وتطبيق القوانين وتحقيق المساواة العادلة بين جميع الأفراد لحساب الدولة العصبانية القائمة على الولاء والخضوع والخنوع لصاحب الشوكة أو العصبة. وللوصول إلى الحلول المقبولة لهذه المشكلة علينا أولًا فهم هذه الحالة العربيّة التي لم تحظ بالاهتمام الكافي، وظلت الدراسات التي تتعلّق بها محصورة بدراسة ابن خلدون ونظريته. ولهذا وانطلاقًا مما ذكره المفكر المغربي محمد عابد الجابري،[2] في مقالة له عن الديمقراطية، أنّ الهدف من أي طرح ينطلق من ثلاثة أسئلة، وهي: من أين نبدأ؟ وكيف؟ وإلى أين نريد الوصول؟ (الجابري، الانتقال إلى الديمقراطية في المغرب، موقع الدكتور محمد عابد الجابري، 2000)ولنعرف من أين نبدأ؟ وكيف نبدأ؟ يجب أن نعرف الواقع الذي نريد تغييره معرفة حقيقية تسهّل علينا تغييره، لذلك جاء اهتمامنا بموضوع العصبية، فالهدف من هذا البحث هو فهم الواقع الذي تعيشه المجتمعات العربية لمعرفة كيف يمكن تغييرها من أجل التحول إلى مجتمعات ديمقراطيّة.تسعى هذه الدراسة إلى محاولة رسم صورة كاملة للواقع العربي من خلال دراسة ثلاثة عناوين تناول كتّابها موضوع العصبية في المجتمعات العربية الحديثة، بدءًا من حركة هذه العصبية في المجتمعات وصولًا إلى النتائج المترتّبة عن هذه الحركة.علمًا أنّ الدراسة لا تسعى إلى اقتراح حلول للواقع الراهن، إنما الهدف منها قراءة هذا الواقع علّنا نستطيع بعد فهمه، الانتقال إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة البحث عن حلول واقعيّة. لذلك هي لا تطرح أيّ حلّ يقوم على عقد جديد غير العقد القائم اليوم في الدول العربيّة، وإنّما دراسة نحاول من خلالها فهم العقد الاجتماعي القائم في الدول العربيّة الذي يبدو في ظاهره حداثيًا وديمقراطيًّا، في حين أن الوقائع تثبت انعدام تحقق القيم الحداثية. وهذا ما أثبته غياب التوافق السياسي بين جميع الأطراف الحاكمة وغياب أي حوار اجتماعي بنّاء بين أبناء الوطن الواحد.تعدّ الدراسة مصطلح "العصبية" الركيزة الأساسية التي تتحكم بمجمل العملية السياسية العربية اليوم، كما تلحظ أنّ النخب القديمة قد أعادت تشكيل ذاتها، لكن بشكل حديث فأعادت بناء الدولة المستبدة مستندة إلى ما يسمّى العصبيات.يُظهر عنوان البحث: "من الصدام إلى الاستلاب، رحلة المجتمعات العصبانية في أوطان مهدورة" أنّ رحلة المجتمعات العربية هي رحلة مختلفة جدًا عن المجتمعات الغربية، لذلك جاءت الغاية من التركيز على فهم الواقع العربي الخاص بعد أن تمّ تجاهل هذه الظاهرة لسنوات عديدة.
· إشكالية البحث:
تشكّل العصبية أحد المعوّقات الأساسيّة في عمليّة بناء الدولة الحديثة القائمة على الديمقراطيّة والحريّات وحقوق الإنسان، وهي تظهر على صور مختلفة لتؤدي دورًا واحدًا، فما هو هذا الدور الذي تؤديه؟ وكيف تمارسه؟ وما هي النتائج المترتبة عن حركتها في المجتمعات العربيّة؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة نعتمد على ثلاثة عناوين لكتب تناولت موضوع العصبية بالبحث والتدقيق وهي:- صدام العصبيات العربية، فردريك معتوق، بيروت منتدى المعارف، 2017.- العصبيات وآفاتها، استلاب الأوطان وهدر الإنسان، مصطفى حجازي، بيروت، المركز الثقافي العربي، 2019- العصبيات آكلة الحريّات السياسة، فردريك معتوق، الفصل السادس عشر من القسم الخامس من كتاب الحريّة في الفكر العربي المعاصر، مجموعة مؤلّفين، قطر، المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسة، الطبعة الأولى، 2018(...)**** باحثة لبنانية، تعدّ أطروحة دكتوراه في الفلسفة السياسية (الدولة الحديثة والتقليدية في العالم العربي) في المعهد العالي للدكتوراه – الجامعة اللبنانية. وحائزة ماجستير في الفلسفة السياسية من الجامعة نفسها.
[1]- يعود اختبارنا لاستعمال مفرد عصب بدل جماعات انطلاقًا من تحديد محمد عابد الجابري لكلمة عصبة على أنّها الجماعة القبلية التي تقوم على الرابطة العصبية، سواء كانت على مستوى القبيلة أو لها علاقة بفرع من فروعها، وليس من الضروري أن تربط رابطة الدم بين أبناء العصب الواحدة ليكونوا عصبية جامعة قوية، فالعصبية قد تكون بالحلف أو بما يماثله كما يذكر ابن خلدون.
[2]- محمد عابد الجابري (1935-2010م): مفكّر وفيلسوف مغربي، حاصل على دكتوراه الدولة في الفلسفة العام 1970. له عدّة مؤلّفات في قضايا الفكر المعاصر منها: نقد العقل العربي. وترجمت كتبه إلى عدّة لغات أجنبية.
الحداثة (Al Hadatha) – س. 29 – ع. 224 - صيف 2022 SummerISSN: 2790-1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on August 14, 2022 00:06
August 13, 2022
العدالة الدستورية وواقعها في الدول العربية (لبنان، العراق، مصر، الكويت، تونس)


♦ محمد فياض مشيك *
♦ خضر سامي ياسين **
نبذة عن البحث
تطلبت "العدالة الدستورية" مراحل زمنية حتّى تبلورت ونشأت، وظهرت في هذه المراحل آراء متناقضة منها الإيجابي ومنها السلبي، وكانت آراء الفقهاء مساهمة في هذا الخصوص. وقد ظهرت أهميّة العدالة الدستورية بعد الحرب العالمية الثّانية (1939 – 1945)، وظهور الأنظمة الدكتاتورية في أوروبا (النازية والفاشية...). وبعد أنّ انتشرت العدالة الدستورية في أوروبا انتقلت إلى العالم العربي بمراحل مختلفة في كلّ من: لبنان، والعراق، ومصر، والكويت وتونس. ووضعت عدة دول عربية دساتير جديدة تحت ضغط المطالب الشعبية، وما ترتب على ذلك من إحداث إصلاحات دستورية وقانونية.عالجت هذه الدراسة مراحل نشوء العدالة الدستورية في العالم العربي، ودورها في حماية الحقوق والحريات الأساسية، الأمر الذي دفعنا إلى البحث في بعض القرارات الصادرة عن القضاء الدستوري. وتمّ الاستناد إلى بعض اﻵراء الفقهية المشدّدة على أهميّة دور العدالة الدستورية في واقعنا الحالي. وتمثّلت الأهداف الرئيسة للدراسة في مناقشة المراحل التي سبقت وجود العدالة الدستورية في الدول العربية، ثمّ الانتقال إلى البحث في تبلور العدالة الدستورية في العالم العربي وواقعها، خصوصًا أنّ شرعية العدالة الدستورية بنيت على مرتكزين: الأوّل: في رقابة السلطات، والثّاني: يتمثّل في حماية الحقوق والحريات.لا شك أنّ واقع "العدالة الدستورية" تطور في العالم العربي بشكل بطيء نسبيًّا عمّا هو عليه الأمر في الدول الغربية، الأمر الذي يبرز أهميّة هذه المؤسسة على المستويين الدستوري والقانوني. فقد لاحظت هذه الدراسة أن العدالة الدستورية تسود على حماية المجتمعات خصوصًا في حال الجنوح في تغيير أنظمة الحكم إلى أنظمة دكتاتورية وشمولية، فإشكالية تعاقب الدساتير أرخت بظلالها على واقع العدالة الدستورية، خصوصًا في تونس. وأما بالنسبة إلى الجهات المخوّلة بالطعن أمام القضاء الدستوري فما زالت محدودة، وهذا ما هو عليه الواقع في لبنان، وأما بالنسبة إلى طرائق الطعن فوجدنا أنّ الطعن عن طريق الإحالة، ساهم في وجود اجتهادات مميزة في مصر.أبرزت الدراسة في التوصيات أن غالبية الدول العربية خاضت تجربة العدالة الدستورية، وبالتالي إنّ عدم فعالية هذه المؤسسة غير مقبول في وقتنا الراهن، حيث يجب أنّ نراعي عمل المؤسسات الدستورية وخصوصًا مؤسسة القضاء الدستوري من أجل مراقبة السلطات وحماية الحقوق والحريات الأساسية، وأنّ نسترشد في تجارب مجالس ومحاكم دستورية مؤثّرة على الصعد كافّة وخصوصًا على صعيد حماية الحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريًّا، وأن يكون دور ممثّلي المعارضة في المجالس النيابية له بعد إيجابي لا "تعطيلي"، إضافةً إلى ضرورة إعطاء المواطنين حقّ الطعن أمام القضاء الدستوري.الكلمات المفتاحية: دستور، قوانين، عدالة دستورية، حقوق وحريات أساسية، محاكم دستورية، مجالس دستورية***
آثرنا اتّخاذ واقع العدالة الدستورية في عدد من الدول العربية (لبنان، العراق، مصر، الكويت، تونس)، خصوصًا أنّ تجربة الرقابة على دستورية القوانين متفاوتة في هذه الدول، الأمر الّذي يدفعنا إلى البحث في المراحل التي سبقت تبلور العدالة الدستورية وواقعها الحالي في الدول سابقة الذكر.احتلّ مصطلح العدالة منذ القدم حيّزًا مهمًّا لدى الفلاسفة والمفكرين، يقول "أرسطو" (Aristotle): "العدل ضرورة اجتماعية لأنّ الحقّ هو قاعدة الاجتماع السياسي وتقرير العادل هو ذلك الذي يرتب الحقّ"([i]).ليس هذا فحسب، بل إنّ الاجتماع السياسي المعبّر عنه بكيان الدولة، كما لو أنّه حاجة طبيعية عند الإنسان، حيث "يعبر الحكماء عن هذا بقولهم الإنسان مدني بالطبع"([ii]). وفي فكر "نيقولا مكيافيللي" (Niccolò Machiavelli) أنّ: "من يصبح حاكمًا لمدينة حرّة ولا يدمرها، فليتوقع أنّ تقضي هي عليه، لأنّها ستجد دائمًا الدافع للتمرد باسم الحريّة وباسم أحوالها القديمة (...) في الجمهوريات تكون الحياة أفضل والعداء أشدّ، كما أنّ الرغبة في الانتقام تكون أشدّ، فالناس لن تتخلّى عن ذكريات حريتها القديمة بسهولة"،([iii]) الأمر الذي يظهر أهميّة العدالة والحقوق والحريات في حياة الإنسان، حيث شكّلت أفكار الثورة الفرنسية، وإعلان حقوق الإنسان والمواطن إحدى ركائز المهمّة في مجال العدالة وحقوق الإنسان.لاحقًا كان لأفكار رجال الفلسفة والقانون، ومنهم فكر الفقيه النمساوي "هانز كلسن" (Hans Kelsen) وتلميذه الفرنسي "آيسمن" (Esmein)، الأثر الكبير في تطور الأنظمة السياسية والقانونية. إلاّ أنّ الحروب الّتي تركت الويلات والبؤس في أوروبا، بسبب الأنظمة الدكتاتورية التي وصلت إلى الحكم بصورة ديمقراطية، أظهر أنّ البرلمانات قد ينتج عنها أنظمة دكتاتورية وممارسات تنتهك الحقوق والحريات الأساسية، مما أوجد ضرورة إخضاع أعمال السلطة التشريعية للرقابة الدستورية، وبالتالي الحاجة إلى العدالة الدستورية.تعدّ الرقابة على دستوريّة القوانين، من أهمّ الصلاحيات التي تحافظ على الحقوق والحريات الأساسية التي تهدف إلى منع انتهاك النّصوص الدستورية. حيث تشكّلت في بدايتها من رقابة قضائيّة ورقابة سياسية (في فرنسا قبل إنشاء المجلس الدستوري الفرنسي)، إلاّ أنّه كان هناك أسس ومبادئ ساهمت في وجود الرقابة على دستورية القوانين.تأسيسًا على ما سبق، فقد أقرّت معظم الدول الرقابة على دستورية القوانين، عن طريق الرقابة المركزية (في فرنسا...)، أو الرقابة اللامركزية (في الولايات المتحدة الأمريكية...).يركّز البحث على إشكالية ما إذا كانت العدالة الدستورية في العالم العربي، أصبحت قادرة على أداء الدور الّذي وجدت من أجله في الدول الغربية؟ حيث سعينا من خلال بحثنا هذا، إلى الإجابة عن تساؤلات متعدّدة ومنها: كيف كان الحال قبل وجود العدالة الدستورية في العالم العربي؟ وما واقعها اليوم؟وللإجابة عن التساؤلات سابقة الذكر، نلتزم في بحثنا هذا اعتماد المنهج التحليلي النقدي، والتاريخي المقارن والاستقرائي، حيث تمّ استعراض مراحل نشوء العدالة الدستورية وتشكّلها التاريخي في الدول العربية، وبالاستناد أيضًا إلى قرارات واجتهادات القضاء ذات صلة بالمسألة المطروحة، أو على رأي فقهي قد يسهم في دعم موضوع بحثنا.(...)***
* كاتب وباحث لبناني - دكتوراه قانون عام (اختصاص: قانون دستوري) – أستاذ محاضر في الجامعة الإسلامية في لبنان
** كاتب وباحث لبناني - دكتوراه في القانون العام (اختصاص: قانون دولي)- أستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية والجامعة الإسلامية في لبنان
([i]) أرسطو طاليس، السياسة مع مقدمة في علم السياسية منذ الثورة الفرنسية حتى العصر الحاضر للبروفسور بارتملي سانتهيلير، ترجمة أحمد لطفي السيّد، منشورات الجمل، بيروت، ط1، 2009، ص. 100
([ii]) ابن خلدون، المقدمة، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، لبنان، د. ط.، د. ت.، ص. 41
([iii]) نيقولا مكيافيللي، الأمير، ترجمة أكرم مؤمن، مكتبة ابن سينا للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، د. ط.، 2004، ص. 37
الحداثة (Al Hadatha) – س. 29 – ع. 224 - صيف 2022 Summer ISSN: 2790-1785 الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on August 13, 2022 23:53
July 31, 2022
نوافذ: حجر المقامات (نصوص)

فرات إسبر *
قوس اللهِ
أنا لا أُعيدُ الزًّمانَ بأدوراه
بل أَنحني عليْهِ كقوسِ الله
أصطادُ من عَينهِ أيامي،
كالنسَّرِ ينقضُّ على فرائسه.
أعضُّ أطرافَ أصابعهِ،
وبكُلَّ قُوايَ أستشرفُ ما تَركتْ عرّافةُ الغيب
من تَفسيراِتها في دَفترِ الرَّمل.
عندمَا أبكي تنمُو شجرةٌ
وعندمَا أضحكُ يتَمايلُ غصنٌ على غُصن.
وأنا بين سُكرٍ وسُكرْ.
أَعْطني لحْدكَ ياربُّ واسترحْ
إنَّني كالغَيمةِ أهطل،ُ
وأقاومُ مثل نهْر في كتاب الله قد ذكَروهُ.
يَمضيِ إلى بلادٍ مهجورةِ الحروفِ،
نورانَّية المعَاني،
كمّا مريم، كمَا في سُورةِ الشُّعراء
ومن حِضن الرّعدِ أنْهضُ
أُرتبُ الأحرُف في مَعَاني كَلماتيِ
أعْلُو، أنْخفضُ:
الفَاءُ: فَنَاءٌ
الَّراءُ: ُرُؤْيا
الألِفُ: ما نطقَ به الإله
والتَّاءُ: تابوتٌ
أُعْطنيِ لحْدَك يا ربّ واسترح
إنَّ الزمَّان يدورُ وأنَا بينَ عَيِنيهِ قوسٌ وسَهم
أرْميه ِكلَّما هَّبتْ بي روحُ.
***
يا لأَياميِ أفرفطها مثل عناقيد العنب
أُقيمُ الجِنَازَة
أُصلّيِ الجِنازة.
يا لأَياميِ أُفرفُطهَا مثلَ عَنَاقيدِ العنبِ.
وأمضي إلى مغارة ِمريم، أَنامُ، تحتَ جِذْع نخلٍ نحيل
يَميلُ يمينًا، يَميلُ يسارًا مع الريح،
ينحني لكن لا يَنْكسر.
كل هذا كانَ وصلًا بين تيهٍ وتيه.
كُلَّما نَجمةٌ في العلا تلألأت،
وكَلَّما هزت الريحُ أوراقَ الشجر،
أَبكي بنواح ٍعميق.
لا الموجُ يقاضيني،
لا الأسماك تمنحنيُ مائها.
صنارةٌ في فمي، وأُجيدُ الكلام
أجيدُ الغزل
رغم تيه الصحراء في جسدي
ينبتُ فيه وَردُ الفرح
وأقولُ ما لم تقله النساءُ لضوءِ القمر.
غير أنّي ساعةً أبكي، ساعةً أضحك،
لأسرابٍ من الماضي، تمرُّ في البال ِونقول عنها، طَلَل.
ما بين يَثربَ والمدينة ِهودجُ الأحلام يمُّر
فقمْ أيها النائمُ في ظلّ الأبد
اطلقْ ما ماتَ من خيلك في أشعارِ العرب
هنا نجمةٌ تلمعُ في أقصى الأرضِ
يظنّنوها السراب
غير أن هذا القمرَ السارحَ فوق الأرض،
يعرفُ المرأةَ التي في أحلامهاِ،
تُقيمُ الجِنازات وتعدُّها مثل عناقيدِ العَنِب.
***
الفضيلة تعرف معنى العطش
الشَّوقُ مَساميرُ الجسد
غابة ٌ تُهْتُ فيها،
ونَسيتُ الرجوع.
ما لها الأرضُ تزدادُ وحشةً
وما بها من أنيس،
غير أنهارٍ تتغيرُ أحوالها في مواسمِ الله.
يا حارسَ البحرِ:
أعدني إلى الخليقةِ الأولى،
كي أصدقَ الحكايات،
كي أزدادَ علمًا،
وأُفضي للخضِر بأسراري.
يا حجَر المقامات ما لك لا تَرقُّ؟
الطريقُ،
يَزدادُ تيهًا إليكَ
بَكىَ الناسُ منك،
من النذور،
وما تراءى لهم ما وراء الحُجُب.
كيف لنا أن نطمئنَ في هذه الأرض التي ُسيجتْ بالتعاويذ؟
كيف لنا أن نفكَ أسرارَ السماء،
أو نفتحَ في الأرض ثقبًا كي نرىَ ما نُألَ إليه؟
الفضيلة تعرفُ معنى العطش
والبراءة الأولى لم يعد لها شبيهًا في هذا الزَّمان
**** شاعرة من سورياالحداثة (Al Hadatha) – س. 29 – ع. 224 - صيف 2022 Summerالحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on July 31, 2022 06:41
June 21, 2022
مجلة الحداثة: معايير الإعلام الرقمي وقراءة في ثورات الربيع العربي- ربيع 2022
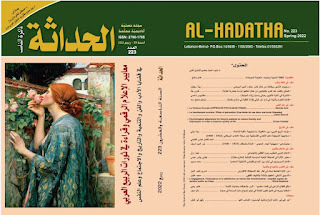
صدر العدد الجديد من مجلة الحداثة - al hadatha journal – فصلية أكاديمية محكمة (ربيع 2022 – عدد 223) تحت عنوان: معايير الإعلام الرقمي وقراءة في ثورات الربيع العربي – في قضايا الأدب والفن والتنمية والتاريخ والاجتماع وعلم النفس.ضم عدد المجلة التي تصدر بترخيص من وزارة الإعلام اللبنانية (230 ت 21/9/1993) – ISSN: 2790-1785 - ويرأس تحريرها فرحان صالح، عددًا من الملفات والأبحاث الأكاديمية، واستهل بافتتاحية، تحت عنوان: الثقافة الشعبية وتحديات "العولمة المتوحشة" للدكتور كامل صالح. وضم ملف في اللغة والأدب: مستويات التأشير ووظائفه من خلال كتاب "خالد" لأمين الريحاني للدكتورة زينة سعيفان، والصّدْق والكذب عند العرب واللبنانيين من خلال أمثالهم (دراسة حضاريّة مقارنة للدكتور فارس حنّا، والشِّعريَّة في أغنية الأخوين رحباني ("سَوا رْبِيْنَا" أنموذجًا) للباحث مطانيوس ناعسي، وظاهرة الذكورة وتأثيرها في شعر نزار قباني (قراءة ثقافية في نماذج مختارة) للباحث العراقي إبراهيم صالح سعد.وضم ملف في علم النفس:La Violence Sociale (APPROCHE PSYCHANALYTIQUE) - Désirée Azzi & Le harcèlement scolaire: Effets et prévention (Une étude de cas dans une école libanaise) - Joëlle Kharrat & Psychological adjustment for dialysis patients to reduce Anxiety and Depression in order to improve quality of life - Eliane Haddadأما ملف في التاريخ، فشمل الأبحاث الآتية: "ثورات الربيع العربي" بين "العفويّة" واستراتيجية "القوة الناعمة" للدكتورة زينه حبلي، واستراتيجية الصهاينة داخل الأراضي الفلسطينية إبان مرحلة الانتداب البريطاني (1922 – 1948) للباحث العراقي أحمد فاضل عباس الفلاحي، وجابوتنسكي- صهيونية الجدار الحديدي - النشأة والمواقف (1925- 1940) للباحث نور الدين شريف.وشمل ملف في الإعلام والفنون: الإعلام العربي المكتوب ودوره الثقافيّ والاجتماعيّ للدكتورة ليندا رزق، ومعايير الإثارة في الصحافة الرقمية السياسية اللبنانية (نماذج مختارة) للباحث والإعلامي طوني بولس عيسى، وظاهرة السيمبوزيوم في لبنان بين الابداع والفوضى التشكيلية المعاصرة للدكتورة محمد حسين.أما ملف في القانون والاجتماع والتنمية، فضم: دور الإرادة كضابط إسناد في إطار عقد الاستهلاك الإلكتروني للدكتورة نسرين ناصر الدين، والتسويق الشبكي: المفهوم والنشأة والتكييف الفقهي للدكتور الليبي محمد علوان.& L’engagement, l’implication et la satisfaction au travail des fonctionnaires - enquête auprès du secteur public au Liban- Ghina Basbous.وواقع القطاع الزراعي في قضاء حاصبيا - الدور والمعوقات وتحديات التنمية للباحثة هاجر يحيى، والمكننة ودورها في تأهيل القوى العاملة في لبنان (نموذج دائرة المساحة في صيدا) للباحثة داليا مزهر.أخيرًا شمل باب مراجعات: أبو علي في "غمام الرّوح وتعاويذ الياسمين": قصّاص الغيم للدكتور رفيق أبو غوش.
الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on June 21, 2022 07:57
June 7, 2022
الافتتاحية: الثقافة الشعبية وتحديات "العولمة المتوحشة"

♦ كامل فرحان صالح *
هل تتجه حركة عناصر الثقافة الشعبية (الفولكورFolklore ) من أعلى إلى أسفل داخل الكيان الاجتماعي، وهي الظاهرة المعروفة في التراث "بنزول الأدب من الطبقة المثقفة أو الصفوة إلى الطبقة الأم أو الطبقة الدنيا للشعب"؟صحيح أن باحثين عرب طبّقوا هذه الفرضية على شواهد عديدة من الثقافة الشعبية لاثبات صحتها، لكن ثمة باحثين آخرين رفضوا المبالغة في هذا الادعاء، وحسبان أن كل أدب الطبقات الأدنى أدب "نازل" من الطبقات الأعلى. وإذا كانت فرضية "ارتفاع" أو نزول" الثقافة الشعبية من "الأدب الرفيع"، تتعلق بطبقة مثقفة هدفها الايحاء بأن الطبقة الشعبية غير قادرة على إنتاج أدب قيّم، يبقى التحدي الأبرز، هو نظرة الأجيال العربية "الخجولة" إلى الأدب الشعبيّ أو رفضه، لظنّها أن هذا الأدب لا يعبّر عن عصرها، وبيئاتها، و"أدواتها الحضارية المستجدة.
- من الريف إلى المدينة
يمكن القول إن عوامل التباين بين الماضي والحاضر مبالغ فيها، لأنه ثبت بالتجربة والممارسة، أنه مهما تغيّرت المؤثرات الاجتماعية، والمظاهر المادية، فإن دوافع أفعال البشر، ومواقفهم من مشكلات الوجود الكبرى، تبقى إلى حدّ ما ثابتة في قسماتها الرئيسة من خلال ما تنتجه من آدابها الشعبية، وإن عبّرت عن نفسها في صور متنوعة. تضاف إلى ذلك، الإشارة إلى أن الملمح الرئيس لأصل الثقافة الشعبية (الفولكلور) عمومًا، والعربي خصوصًا، هو أنه قرويّ ريفيّ، وقبائلي (وحدتها القبيلية)، ويعبّر عن ذلك بأنها مجموعة من الناس لها بناء اقتصادي محدد، فنتج عنه بناء ثقافي متكافئ أو متوازٍ. لكن مع اجتماع الناس في المدن، ووقوفهم على أرضية مشتركة من المصالح المتبادلة، بدا أن تطبيق القاعدة السابقة نفسها، ممكن، وبالتالي نتج من هذا الاجتماع ثقافة شعبيّة تعكس روح ما يعاني منه هؤلاء يوميًّا بحثًا عن لقمة العيش، أو عن أمزجتهم وأفراحهم وأحزانهم، أو عن ردود أفعالهم على الأحداث والوقائع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. لذا لم يجد هؤلاء حرجًا من استعادة أنواع من الثقافة الشعبية (على الرغم من نكران البعض ذلك!)، وصياغتها مجددًا بحسب ما يقتضيه واقع الحال، بحكم ما تتمتع به الثقافة الشعبية من خصائص تتلخص بالمؤلف المجهول، والتناقل الشفويّ، والإنتشار والتداول، والتعبير عن وجدان الجماعة، إلخ.ولا شك، إن التفاعل المستمر بين الأدبين الشفويّ والمدوّن، قد يساعد في هذا البناء الثقافي، لاستعارة مؤلفي الأدب المدوّن حكايات وموضوعات وتقنيات من الأدب الشعبيّ، والعكس صحيح أيضًا.وإذ يبدو أنه من المسلّم به، قبول خضوع أنواع من الثقافة الشعبية لقانون الموت والتحول والتطور، مثلها مثل كل الأنوع الفنية الأخرى، فإن الثقافة الشعبية (الفولكور) في المحصلة (ولا سيما الأدب الشعبي)، هي "التراث الروحي للشعب"، ويطابق هذا التعريف توصيات وفود مؤتمر أرنهايم (Arnhem) الذي عقد في هولندا (Holland) في العام 1955، وعبره يصل الإنسان إلى القصد بتعبير أقصر على مختلف درجاته في الثقافة والإدراك، فهو "من حيث تعريف البلاغة (مطابقة الكلام لمقتضى الحال) موافق كل الموافقة لهذا التعريف".
- الشرخ
لكن، على الرغم من الارتباط الثابت للثقافة الشعبية بالناس، ثمة شرخ في النظرة إلى هذا الثقافة، عُبّر عنها في تاريخ الأدب، بالاهمال حينًا، وبالنكران حينًا آخر، لمصلحة الأدب المدوّن؛ فبات هناك أدب "رفيع" يعبّر عن شرائح السلطة بتلاوينها كافة، وأدب "وضيع" يعبّر عن الشرائح الفقيرة أو تلك المرتبطة بالأرض أو بممارسة المهن والحرف.ويمكن القياس مكانيًّا أيضًا، للقول: هناك أدب يرتبط بالمدن، وأدب يرتبط بالريف والقرى، أو بتلك الأحياء المكتظة بالسكان، المحيطة بالمدن.وإذ لم يعد خافيًا، أن العالم اليوم يعيش في عصر عولمة متوحشة (Wild Globalization) فإن هذه العولمة قادرة على جعل كل الثقافات، بما فيها الثقافة الغربية، بلا أي مضمون، وتتمحور بأكملها حول قيمة واحدة هي التقليد (Imitation) الذي يمكن عدّه القيمة التي تقولب كل القيم في عصر العولمة. وهذه العولمة أيضًا قادرة على "اضفاء صفة الحاجة على ما هو زائد عن الحاجة"، وبات الناس يتعرفون على أنفسهم في بضائعهم، ويجدون جوهر روحهم في هواتفهم الذكية وأجهزتهم الإلكترونية وسياراتهم....وإذا ثمة صعوبة بالغة اليوم في تحديد حجم التأثير السلبي للعولمة في الأدب الشعبي (الفولكلور) لكل دولة ومجتمع وشعب، إلا أنه بات في الإمكان أن يلمس المرء أنه يخسر شيئًا فشيئًا جزءًا من مكوّنات هويته الثقافية التي تميزه إيجابًا عن الآخر، مقابل اكتسابه "ثقافة" تجعل منه مقلدًا وتبعيًّا، بل ومدمنًا على كل ما تنتجه منظومة العولمة التي تجسد ضمن هذا السياق "الآخر"، لظنّه أن الحياة المعاصرة الحقّة هي في الأخذ بهذه المنتجات، واستخدامها، واللحاق بكل جديد تنتجه، والاعتماد عليها اعتمادا كليًّا. وما هي في الحقيقة سوى ثقافة مصطنعة (Culture Industrial) ينتجها النظام العالمي إنتاجًا، أي ثقافة زائفة تقف في مقابل الثقافة الشعبية الحقيقية الناتجة تلقائيًّا من تفاعل البشر بعضهم البعض في إطار حركية المجتمعات لا تماثلها كما هي سياسة العولمة.
- الوهم
إذا كانت فرضية "ارتفاع" أو نزول" الثقافة الشعبية من الأدب الرفيع، تتعلق بطبقة مثقفة هدفها الايحاء بأن الطبقة الشعبية غير قادرة على إنتاج أدب قيّم، يبقى التحدي الأبرز، كما أشرنا أعلاه، هو نظرة الأجيال العربية الخجولة من الثقافة الشعبية أو الرافضة إياه، لظنّها أن هذه الثقافة لا تعبّر عن عصرها، وبيئاتها، و"أدواتها الحضارية المستجدة"، ولا سيما في زمن العولمة، حتى بات مدلول لفظة "شعبي" يعني الابتذال والوضاعة والتفاهة وعدم الجودة والاتقان! لكن يفوت معظم هؤلاء، أن محاكاتهم وتقليدهم لما يصدر عن الآخر/الغرب، هو نوع من محاكاة الآداب الشعبية لما تنتجه هذه الشعوب على غير صعيد، وتحديدًا في العادات والتقاليد اليومية، والأزياء...، والمأكل والمشرب (بيتزا Pizza، همبرغر Hamburger، سباغيتي Spaghetti، المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة...)، ومن دون نسيان التأثر بأبطال ما تنتجه هذه المنظومة من حكايات وأساطير وأفلام سينمائية، وربما أقرب تمثيل على هذا الوضع، هو ما تنتجه السينما الأميركية من عناصر شعبية لم تأتِ من الماضي، بل من الحاضر والمستقبل، كالأساطير والحكايات التي تعرضها من أمثال:الرجل الخارق، المتفوق، القوي الذي لا يقهر سوبرمان (Superman)، وحماية العالم من خطر كارثيّ متوقع (Save the world)، أو عبر ما تخترعه من رحلات وهمية إلى المستقبل (Trips to the Future)، أو العودة إلى المستقبل (Back to the Future)، أو العودة من هذا المستقبل إلى الحاضر لاصلاح خلل (ماBack from the Future)، أو قدرة الإنسان على التحول إلى كائنات أخرى (Mutant) وغيرها الكثير.
- الخضوع
ما يبدو مربكًا حقًا هو استمرار هذه الأجيال العربية بالتقليد الأعمى، ويزداد هذا الوضع سوءًا مع خضوعها للعبة العولمة من دون طرح أسئلة، فيجد المرء مثلاً، أن ما حلّ محل الأدوات والأشياء والعناصر التي كان يستخدمها الإنسان يوميًّا، حافظت العولمة على المهمة التي وُجدت لأجلها، إنما ما فعلته، هو تغيير صناعتها والمادة التي تنتجها، لتصبح قابلة للاستهلاك السريع.لذا، يلحظ مثلاً أن الفخّاريات اختفت ليحلّ محلها البلاستيك والألمنيوم؛ فالإبريق بقي يستخدم للماء، إنما بدلاً من أن يكون من فخّارٍ صُنع محليًّا، أصبح يُستورد من الخارج، ويُصنع من مواد يُعتقد أنها مسببة للكثير من الأمراض. كذلك، تراجعت الثقافة العمودية/المتعمّقة، لتحلّ محلها الثقافة السطحية/الشاشة، وأطلق الرصاص من كل حدب وصوب على الحليب الطبيعي، ليتقدم محلّه حليب البودرة، وشُوّهت الذائقة، فبدلاً من تناول العصائر الطبيعية تجد العصائر المعلّبة والمصنّعة هي المنعشة، والمناسبة للأمزجة في كل وقت وزمان.فوق هذا وذاك، وسمت الأساطير والأغاني الشعبية والحكايات الشعبية، بالبدائية (بالمفهوم السلبي)، والمثيرة للغرائز، والوهم، والتخلف، لتحلّ محلها أساطير السينما الهوليودية...، أي تنميط الفن، وخلق الأيقونة/ المثال.إن هذه الوضعية التي طرحت نفسها على أنها البديل من الثقافة الشعبية (الفولكلور)، يمكن رؤيتها ومتابعتها من حيث الممارسة عبر مسارين:· "الأول: مغالاة البعض بالتقليد الأعمى للآخر، وكأننا من دون ثقافة وتاريخ وجغرافيا.· الثاني: مغالاة البعض بالعزلة، واحتقار ثقافة الشراكة والتواصل داخليًّا وعربيًّا.فهل تعي الأجيال العربية، أن ما تخجل منه أو تهرب منه في ثقافتها الشعبية بحجة قدمه، وعدم صلاحيته للعصر، هو إلى حدّ ما، نفسه الذي تتأثر به وتتبناه لدى الآخر، إنما بأشكال وصور وتعابير وصيغ مختلفة؟وهل يعيش هذا الجيل – حقًا- في "قرية صغيرة"، وهو شعار العولمة الأثيري؟وإذا لديه الرغبة في العيش في هذه القرية فعلاً، والانتماء إليها، لماذا يهمل قريته الخاصة التي تشكل تميزه وهويته، وعلامته الفارقة في هذا العالم؟
- أخيرًا
يمكن التأكيد في الخلاصة، أن الثقافة الشعبية حيّة، ترتبط بالحياة وتتفاعل بها ومعها وفيها، وتفسح في المجال للتعرف إلى شخصيتنا الحضارية، وواقعنا النفسي والاجتماعي، وتلقي مزيدًا من الضوء على بعض مضامين اللاوعي الجمعي، وأن هذه الثقافة ما زالت تمتد على نحو من الأنحاء، في واقعنا المعاصر، وتمثل بعدًا مهمًا من أبعاد شخصيتنا، فهي أكثر صدقًا في إعطاء الصورة الحقيقية للعملية الاجتماعية، إذ تساير الفطرة التي تتجلّى في حَبْك الأدب، وطريقة إبداعه المتغيرة، من بيئة لأخرى، ومن زمن لآخر، كما تتجلى الفطرة والتلقائية في لا منطقية السرد، والربط بين الأحداث، بعكس الأدب الرسمي الذي يعتمد على الربط والمنطقية، فموضوع الأدب الشعبي عام، يمسّ كل فرد من أفراد الأمة، وهو أيضًا خاص، يحسّ كلّ فرد بأنه موضوعه الشخصي الذي يهمّه وحده، أو يهمّه قبل أي شخص آخر...أخيرًا إن اصرار "الأجيال العربية" على إطلاق الرصاص على ثقافتنا الشعبية كونها شيئًا "متخلفًا" (وهذا غير دقيق كون ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي ما هو إلا ثقافة شعبية)، يجعل حاضر هذه الأجيال ومستقبلها "جهنمًا". وهذا للأسف ما يحدث!***
* أستاذ دكتور في الجامعة اللبنانية
الحداثة (Al Hadatha) – س. 29 – ع. 223 - ربيع 2022 Spring ISSN: 2790 -1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha
Published on June 07, 2022 09:03
مجلة الحداثة - Al Hadatha Journal
Al Hadatha Journal - A Refereed Academic Quarterly
مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة
تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)
ISSN/2790 Al Hadatha Journal - A Refereed Academic Quarterly
مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة
تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)
ISSN/2790-1785
تُعنى المجلة بنشر الأبحاث الأكاديمية بعد عرضها على لجنة علمية متخصصة. وتبلورت فكرة نشوء المجلة بعد اجتماعات عمل متواصلة بين رئيس تحريرها فرحان صالح وأصدقاء باحثين وأكاديميين من لبنان والعالم العربي، وقد بات عدد منهم ضمن الهيئة الاستشارية للمجلة، علمًا أن بعضهم قد فارق الحياة، وقد جرى إضافة أسماء إلى الهيئة لاحقًا. تغطي مجلة الحداثة الأبحاث التي تأتي من شريحة واسعة من الأكاديميين والمفكرين والكتّاب والأدباء في لبنان والعالم العربي، فتنشر موضوعات تتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والسياسية، كذلك، موضوعات تتعلق بقضايا فكرية وتراثية وأدبية ونقدية وفنية وإعلامية ...more
مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة
تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)
ISSN/2790 Al Hadatha Journal - A Refereed Academic Quarterly
مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة
تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)
ISSN/2790-1785
تُعنى المجلة بنشر الأبحاث الأكاديمية بعد عرضها على لجنة علمية متخصصة. وتبلورت فكرة نشوء المجلة بعد اجتماعات عمل متواصلة بين رئيس تحريرها فرحان صالح وأصدقاء باحثين وأكاديميين من لبنان والعالم العربي، وقد بات عدد منهم ضمن الهيئة الاستشارية للمجلة، علمًا أن بعضهم قد فارق الحياة، وقد جرى إضافة أسماء إلى الهيئة لاحقًا. تغطي مجلة الحداثة الأبحاث التي تأتي من شريحة واسعة من الأكاديميين والمفكرين والكتّاب والأدباء في لبنان والعالم العربي، فتنشر موضوعات تتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والسياسية، كذلك، موضوعات تتعلق بقضايا فكرية وتراثية وأدبية ونقدية وفنية وإعلامية ...more
- مجلة الحداثة's profile
- 11 followers



