عبـــــــدالله خلــــــــيفة's Blog: https://isaalbuflasablog.wordpress.com , page 69
December 16, 2021
عبـــــــدالله خلــــــــيفة : المنبتون من الثقافة الوطنية
واجهتْ الثقافة الوطنية الديمقراطية تحدياتٌ كثيرة في سبيلِ تشكيل نفسِها، وزرعِ وجودِهِا في الأرض، لهشاشةِ الجذور الثقافية لها، وعدم ترسخ الأنواع الأدبية والفنية، وقد تنامت بذورُهُا مع تنامي الحركة الوطنية الديمقراطية، أي بقدرِ ما تتخلص الحركات السياسية من جمودها وشموليتها، وبقدر ما يقدر المبدعون على تحليل العلاقات الاجتماعية التقليدية ونقدها وتجاوزها.
وقد تنامت الرؤى الشمولية في هذه الثقافة عوضاً عن ضعفها وزوالها، بسببِ تحكم المؤسساتِ العامة البيروقراطية في مصائر الثقافة، وخلخة تماسك المبدعين وحفرهم في الواقع ونقده، وهو الشرط الضروري في تنامي أي إبداع.
وكل هذه المؤثرات لعبت أدوارها في زعزعة الثقافة الوطنية وتقزمها، وتنامي دوران الكتاب والفنانين والمثقفين حول ذواتِهم ينسجون شرانقَ من وهم، ويكرسون أنفسهم وقد انعزلت عن عمليات تحليل الواقع ونقده، سواء عبر عوداتهم لوعي الطوائف وأندماجهم في مشروعاتها السياسية التفكيكية، ومزايداتهم على هذا الوعي أحياناً، عوضاً أن يتغلغلوا إلى نواته الوطنية ويبرزوها وينقدوا تجلياتها الطائفية ويخلقوا التلاحم بين الجمهور.
أو جعلهم ذواتهم هي البؤرُ الوحيدة في الكون الثقافي، فلم يعدْ ثمة وطنٌ ولا جبهاتٌ ثقافية يمكن أن تكرس شيئاً من الوعي الديمقراطي الحقيقي في الجمهور، فجربوا حتى ضاعوا، وانعزلوا عن القراءة وتطوير أدواتهم، أو راحوا يكررون ذواتهم الجامدة بصور شتى، حتى فقدتْ التجاربُ التي يقومون بها أهميتها ودورها، ولم يعد ثمة فارق بين مبدع كرس نفسه لعقود وبين ناشيء، بل قدرَ الناشىءُ أن يبز المعتق عبر أساليب هزيلة وإدعاءت بخلق فن جماهيري وما هو بجماهيري بل تخديري، يعتمد التسلية الفجة.
وهناك مظاهر شتى لذلك فكلها تعبيرٌ عن خلخلة وعي فئات وجدتْ إن مصالحَها هي كلُ شيء، ورنتْ إلى كراسيها وأرصدتها، وباعتْ تاريخاً، وتخلتْ عن تقنياتٍ وأدوات توصيل وحولتْ المنابر الفنية والأدبية إلى تكريس لشخوص وشلل وليس لمراكمة وعي ديمقراطي ثقافي يعيد بناء الثقافة الوطنية الخربة.
وتتشكلُ معطياتٌ جديدة لتجاوز ذلك عبر الدفاع عن مصالح الفنانين والكتاب ومؤسساتهم ونتاجاتهم، وتغيير هذا المستوى المتدني لظروف إنتاجهم الثقافية والشخصية، بشكلٍ جماعي وليس بأشكالٍ فردية، بحيث يتم تغيير جوانب هامة من الوضع الثقافي كدعم مغاير لهذا الدعم الهزيل الراهن، بحيث يزيل دور مؤسسات الثقافة المتسولة، ويضع قانوناً للتفرغ وليس لشراء بعض المبدعين، ويقيم مسارح ومكتبات وثقافة منوعة كبيرة للطفولة، ويحرر التلفزيون من سطوة الشلل، ويجعل للفنانين والأدباء ضماناً اجتماعياً مواكباً لدورهم الوطني، ولا يجعل من المثقفين منبوذين في أرضهم محتفى بغيرهم من كل الأصقاع!
وأن لا يأتي ذلك عبر التسول كذلك بل عبر استخدام الأدوات النضالية المتوفرة من مجالس منتخبة ونقابات، وإذا حدث أن لم تستجب الدوائر البيروقراطية لهذا وفضلت العمل عبر الشلل وتكريس المثقف المهرج والشاعر الشحاذ، والفنان المتعطل من الموهبة، فلتتواصل اللجان المشتركة للمثقفين، وتحفر في الواقع سواء عبر تعضيدها لنواب ديمقراطيين، أو بتصعيد نتاجها وتغيير طابعه الانعزالي غير المفيد وتتعلم مرة أخرى كيف تتكلم مع الناس.
December 12, 2021
عبـــــــدالله خلــــــــيفة : علم الحشرات السياسية
 عبـــــــدالله خلــــــــيفة
عبـــــــدالله خلــــــــيفة
لا تستطيع بعض النوعيات السياسية إلا أن تتعيش على إنتاج غيرها، فليس لديها قدرة على الإنتاج وإذا توجهت للإنتاج فهو إنتاج ضئيل، لا يتناسب مع حجم تصوراتها عن نفسها العملاقة، وعن أهدافها الطموحة.
وبسبب أن الطموحات السياسية الكبيرة تحتاج إلى إنتاج فكري كبير وعلى بلد يستوعب هذه الطموحات، فهذه النوعيات تعيش حالة من الاندفاع الهائل ثمة حالة معاكسة من الإحباط القاتم!
في زمن الاتحاد السوفيتي تنتفخ عضلاتها السياسية، وفي زمن أزمة المنظومة (الاشتراكية) تتهم المصلحين والباحثين في بلدهم عن حلول لأزماتهم بأنهم خونة ومرتدون، فهي تريد بلداً كبيراً جاهزاً يساعدها، حتى على المستوى البسيط التافه، مثل أن المناضل يريد إرسال أبناءه للدراسة المجانية، في حين أن الدراسة تحولت إلى دراسة بالمال، ولم يعد ثمة جامعات سياسية، شهاداتها أغلبها غير علمية.
ومثلما أن ظروفه تحتاج إلى أن يشتغل ويتعلم ويتطور فكرياً وسياسياً لكنه لا يريد أن يتعب، يريد كلَّ شيءٍ جاهزاً مثلما كان الاتحاد السوفيتي جاهزاً بالنظرية وبالمطاعم وبالفودكا!
هذا يحدث للمناضلين للقومويين الذين يريدون كل شيء جاهزاً من القيادة القومية: النظريات والكتيبات والتعليمات، وحين تختفي القيادة القومية، خاصة شيكاتها فإن العالم يغدو دماراً، ولا يستطيع المناضل إلا أن ينتظر ثدي نظامه الحنون ليسقيه بالحليب السياسي الصناعي!
وهذا يحدث للمناضلين المذهبيين السياسيين الذين يزعمون بأنهم مناضلون إسلاميون، وهم أقوياء لأن الضخ المالي والسياسي لا يزال مستمراً، فالتعليمات والأشرطة والكتيبات والشيكات لا تزال متدفقة، ولهذا هم (إسلاميون) وحين تتوقف الإرساليات سيفكرون في أفكار أخرى، أكثر تعبيراً عن قضية الوطن والأمة!
لا بد للجماعات السياسية التي تعيش على الانتفاع من حماس يغطي عيون الفقراء ويصور الانتفاع بأنه تضحيات كبرى، وهناك أناس مخدوعون وطيبون حتى بين هؤلاء، لكن زبدة المرحلة حين يتم خض المصالح لا تتحمل إلا العدد المحدود لأن الدول لا تستطيع أن تدفع للجميع!
ويقوم هذا العدد القليل بفلترة الاندفاع والحماس والحكمة وبعد النظر والإصرار والمقاومة والعلوم، ويحولها إلى سن سيف مكسور، ففي ساعة اعتماد الشعب على التنظيم الطليعي يتحول التنظيم الطليعي إلى خروف لا يصلح حتى للذبح في عيد الأضحى!
تسرب الحشرات إلى التنظيم يتم تدريجياً وبعد سنوات عديدة يرى أصحابه أنه لم يعودوا قادرين على فعل شيء حقيقي، بسبب السماح للحشرات بالعيش طويلاً في غرف التنظيم المناضل، وهذه الحشرات تبحث عن السكر فتمصه حتى تحول قصب التنظيم إلى أعواد يابسة تتكسر!
من هنا ضرورة أن تكون التنظيمات قليلة العدد، معتمدة على نوعيات منتجة، كثيفة العمل، قليلة الكلام، كثيرة الفعل، لا تفكر بمصالحها وتنفيع أقربائها وأصدقائها، تبحث عن هموم المجتمع وقضاياه لا عن انتظار العون الخارجي ومنافع المؤتمرات والسفرات والرحلات.
لو كانت التيارات السياسية تيارات نحل ونمل، أي تيارات إنتاج وخلق، لكن الانتماء جدياً ولكن هناك نوعاً آخر من الحشرات يطن ويؤذي وينشر الميكروبات!
#المنبر_التقدمي
__ATA.cmd.push(function() { __ATA.initDynamicSlot({ id: 'atatags-26942-61b69fc9ca61e', location: 120, formFactor: '001', label: { text: 'الإعلانات', }, creative: { reportAd: { text: 'الإبلاغ عن هذا الإعلان', }, privacySettings: { text: 'الخصوصية', onClick: function() { window.__tcfapi && window.__tcfapi( 'showUi' ); }, } } }); });December 11, 2021
عبـــــــدالله خلــــــــيفة : الكائنُ الذي فقدَ ذاته
أرقصْ على حبال الطبقات والتيارات وأرفعْ مصلحتكَ الخاصة لدرجة المقدس.
كنْ مع الحركة إذا رفعتك وقربتك من السلطة والمغانم وأهربْ عنها إذا حرقت شعرةً من جلدك.
كنْ ضدها إذا خسرتْ ولا تقطعْ الخيوطَ تماماً فربما أعطتك شيئاً في مستقبل الأيام.
كنْ مع الاشتراكية إذا كانت كراسٍ وتذاكرَ ودراسة مجانية وأبناءً يذهبون للنزهة.
لكنك دائماً مع الرأسمالية، هذه الملعونة اللذيذة.
كنْ مع اليسار إذا أغنى أهل اليسار، وكن مع اليمين إذا صعد نجمُ اليمين.
كن مع الالحاد إذا كان مفيداً وساعتهُ دانية وكنْ مع الإيمان إذا كانت قطوفه دانية.
كنْ ماركسياً تقدمياً حيث لا ضررَ ولا ضرار والجمهورُ الكادحُ يعطي تضحياته لها، وكنْ دينياً طائفياً حين ينقلب الجمهورُ ويصبحُ منشئاً لحصالات الخير والتبرعات ويسفكُ دمَهُ من أجل الخيال.
أنت أيها الراقصُ على حبال الطبقات والتيارات، يا لك من ذكي في زمن الغباء السياسي.
قامتك تصلُ للسماء وأنت تمشي وراء جيفارا وكاسترو وهوشي منه وتدقُ طبولَ الثورة في الغابات العربية الصحراوية، تحملُ بندقيةً من خشب وتقاتلُ في الفضاء، ولكن لا مانع من استثمار أبناء هوشي منه في المصانع والسكوت عن الاستغلال الفظ للملايين منهم.
إذا جاء زمانُ الثورة العمالية والاشتراكية فأنت إشتراكي لا تقبلُ بربطةِ عنق برجوازية، وتدينُ الإكراميات وإنشاء المتاجر عند اليساريين المتخاذلين الانتهازيين، ولكنك لا تمانع من المتاجرة بالدولارات في الاشتراكية وبيع البضائع المهربة بالسر في روسيا السوفيتية.
جاء زمانُ الطائفيين ففجأة إكتشفتْ طائفتك، وبكيتْ على ماضيك الإلحادي، وكراهيتك للمساجد والمآتم حسب تصنيفك الطائفي، وعرفتْ مزايا مذهلةً في هؤلاء الطائفيين المقاتلين من أجل الديمقراطية وحقوق الجماهير، أو لكونهم عقلاء يؤسسون رأسمالية بنوك الخير ومساعدة الشعوب وينخرون الحكومات والأنظمةَ بدأبٍ من أجل مستقبلِ رأس المال الطفيلي، وفي الإمكان أن يقفزوا للسلطات فجأة. فأنتَ دائماً مع الخير وتقدم الشعوب والموجة الغالبة.
مع الدولةِ والرواتبِ المجزية والعلاوات والبقشيش ومع المعارضةِ الطائفية تضعُ في صندوقَها الأسود بطاقةً للمستقبل، وربما يحضرُ مقعدٌ عال في قادم الأيام، فالعاقلُ لا يفلتُ فرصةً.
مع الاشتراكية هناك ومع الشيعة هنا، ومع السنة هناك ومع الربيع ومع الخريف حسب الأسعار، ومع الألوهة ومع الإلحاد، ومع المقاومة ومع التراكمات النقدية حسب الطلبات الوطنية والعالمية والشركات المتعددة الأيديولوجية.
التناقضاتُ تملأكَ ولكنها لا تدمرك، كيف تُدمرُ حصالةٌ؟ وكيف يفلسُ بنكٌ إيديولوجي سياسي متحرك؟!
التناقضاتُ تصيبُ المناضلين الخائبين الذين لا يغيرون مبادئَهم حتى في الأعاصير، الذين إذا قلّ أنصارهم بقوا، وإذا كثروا لم يغتروا. يكتفون بضلع من بناية، ويزدهرون في البساطة والشظف والفرح.
أما أنت فعملاقُ عصرك ترتفعُ عن هؤلاء المحنطين، وتزدهرُ أسهمك ومدخراتك، وترهفُ السمع لأي تغير في الذبذبات السياسية والمالية، وتزحف وتزحف حتى تهترئ نفسك ولا يبقى عظيمٌ في روحك، تتحسُّ موجات الهواءِ الصغيرة لتتعرف الاتجاه القادم وتبقى في الاتجاه السائد.
قدمٌ في الرأسمالية وقدم في الاشتراكية، قدم في اليسار وقدم في اليمين، قدم مع الإرهابيين وقدم مع الشرطة العربية حسب مسار الأسهم.
هؤلاء أعداؤك الذين كانوا يريدون قتلك فكيف تظهر بينهم وتزرعْ زرعهم، وهذه أوراقكَ كيف توقفت وأهترات، وهذا مسرحك كيف هدمته، وهذه أدبياتك كيف توقفت وهذه صحفك كيف أهترأت، وهذه خطاباتك كيف مُحيت، وهذا تيارك كيف دمرته، وهذا شعبك كيف تلاعبتْ بمصيره؟
القائد والمناضل عبـــــــدالله خلــــــــيفة مفكراً وأديباً وروائياً بحرانياً
 كريم مروة
كريم مروة تميّز عبـــــــدالله خلــــــــيفة بالجمع في شخصيته بين المفكر اليساري والأديب والروائي والمناضل الذي لم يتراجع في كل الظروف عن أفكاره وعن مواقفه. وقاده إلتزامه بأفكاره التي دافع عنها بشجاعة الى السجن اكثر من مرة. لكن من اهم ما عرف عنه وهو في السجن، الذي أدخل إليه في عام 1975 من موقعه في قيادة جبهة تحرير البحرين، أنه لم يترك القلم لحظة واحدة. وصار معروفاً أنه ألّف عدداً من كتبه ومن رواياته على وجه الخصوص داخل السجن على ورق السيجارة. وكانت تهرّب إليه الأقلام و أوراق السجائر ليمارس عمله الأدبي و الفكري. وكانت تهرّب أعماله الأدبية من السجن و يعاد طبعها بانتظار خروجه من السجن لكي يتم نشرها. وهو بتلك الصفة التي ندر شركاؤه فيها تحوّل الى أيقونة بالمعنى الحقيقي المناضل اليساري الحقيقي و لصاحب الفكر النيّر.
تعرّفت الى عبـــــــدالله خلــــــــيفة عندما زرت البحرين في عام 2000، العام الذي كانت قد تحولّت البحرين من إمارة الى مملكة ذات دستور شبيه بمعنى ما بدساتير الممالك الدستورية. لبّيت يومذاك دعوة المنبر الديمقراطي الذي صار الناطق باسم جبهة تحرير البحرين والبديل منها في الشروط الجديدة. وأشهد أن تلك الزيارة قد عرّفتني الى تاريخ البحرين القديم والحديث. كما تعرفت في الآن ذاته الى العديد من قادة جبهة تحرير البحرين القدامى وقادة المنبر الديمقراطي الجدد. وكانت لي صداقات أعتز بها مع عدد من قادة جبهة التحرير، لا سيما في الزمن الذي كانت الإمارة قد انفتحت على القوى الداخلية والخارجية في عام 1973، وأجرت انتخابات نيابية نجح فيها ثمانية من أهل اليسار.
وكنت قد زرت البحرين قبل ذلك غير مرة في طريقي الى الهند واليابان والفيتنام. ولا أنسى فرحي في احدى تلك الزيارات في عام 1980 عندما وجدت في المكتبات كتباً لمهدي عامل و كتباً لماركس.
في تلك الزيارة الأخيرة المشار إليها تعرّفت الى طبيعة التحول الذي كان يحصل في ذلك التاريخ في البحرين. وقد دعيت الى عدد كبير من الندوات التي تحدثت فيها عن قراءتي لذلك الحدث، الذي كان من أبرز عناصره الى جانب تحول البلاد من امارة الى مملكة دستورية، القرار الذي كانت قد اتخذته السلطات بالأفراج عن جميع المعتقلين واستدعاء الذين عاشوا في المنفى لممارسة حريتهم في البلاد والسماح في تشكيل جمعيات وأحزاب و نقابات ومنابر. وكان ذلك حدثاً مثيراً للدهشة في ذلك التاريخ وفي ذلك الموقع الجغرافي بالتحديد. وكان من بين الذين إلتقيتهم وزراء في السلطة الذين تحدثت إليهم عن معنى ذلك الحدث.
إلا أنني و أنا أستحضر اسم عبـــــــدالله خلــــــــيفة كمفكر وأديب وروائي مناضل لا استطيع الا ان اعلن لنفسي وللقارئ كم كنت معجباً بهذا الانسان. فهو الى جانب ما أشرت إليه من صفات فكرية وأدبية وسياسية كان إنساناً رائعاً بالمعنى الذي تشير اليه وتعبر عنه سمات الانسان الرائع بدماثته وبأخلاقه وبحسه الإنساني الرفيع. لم أقرأ مع الأسف رواياته. لكنني قرأت بعض مقالات وقرأت جزءاً من موسوعته التي تحمل عنوان «الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية». وهو كتاب من أربعة أجزاء يحتل مكانه في مكتبتي. غير أنني وأنا أستحضر اسم هذا الانسان النبيل لا استطيع الا ان أتساءل عن الأسباب الداخلية والخارجية التي غيرت تلك الوجهة التي كانت يعبر عنها ذلك التحول الكبير الذي أشرت إليه.
كريم مروة
December 9, 2021
عبـــــــدالله خلــــــــيفة: جبهة التحرير الوطني البحرينية باقية والمنبر التقدمي شكلٌ مؤقت وعابر
كان لجبهة التحرير الوطني البحرينية دواع موضوعية للنشؤ والعمل ، وقد استمرت طوال عقود الخمسينيات وما بعدها حتى أوائل القرن الحادي والعشرين ، مضفرة بين شعارات الفكر التقدمي العالمي والحركة الوطنية التي نشأت في ظلها ، والتي غذتها بوجودها الجماهيري ، حتى غدت خلال العقود التالية من أهم ركائز الحركة السياسية البحرينية.
لكن في سنوات القمع الطويلة منذ الستينيات حتى التسعينيات من القرن العشرين أُنهكتْ الجماعة بالضربات المتلاحقة والتضحيات خاصة داخل البلد الصغير المحاصر ، فلم يبقْ سوى قيادة خارجية وجماعة صغيرة داخلية مفتتة ، وجاءت التحولاتُ السياسية في زمن الميثاق فأسرعت القيادة الخارجية بالحضور وأنهت عملياً الوجود الرسمي العلني لجبهة التحرير ، حيث انبثقت بعد هذا تجربة (الجمعيات).
لقد حدث في الظاهر ما يشبه الطفرة وبدا أن المسرح السياسي سوف يشهد تجربة ديمقراطية حديثة على الطراز الأوربي ، ولكن كان ذلك أشبه بحلم منه بواقع موضوعي حقيقي ، فالديمقراطية الحديثة لا تتكون فوق جسم سياسي تقليدي.
لقد كان قدوم قيادة جبهة التحرير الوطني من المنفى أعلاناً في الواقع بانتهاء هذه الجبهة على طريقة السكتة القلبية ، والإنهاء البيروقراطي الفوقي ، دون أن يبقى فردٌ من تلك القيادة يعالج هذه الفترة الانتقالية ، أو حتى يحفظ موادها الفكرية والسياسية ، ولتتم المزواجة بين القيادة في الخارج وبين الجسم السياسي المُراد تكوينه في الداخل بشكل علني .
لقد كان خطأ القيادة الأخيرة للجبهة جسيماً ، في عدم تشكيل مرحلة انتقال بين النشاط الخارجي أو السري الداخلي وبين الدخول في تجربة الجمعيات ، كما أنها لم تقرأ حدود (الإصلاحات) المزمع إحداثها ، خاصة الدستور المؤقت الذي صار دائماً .
وهذه القرارات المرتجلة وليدة التعب السياسي ، والطمع المادي ، حتى أوجدت جمعية المنبر التي غدت نادياً خطابياً ومقهى للحوار .
وعموماً فإن التنظيم كان يحتاج لفترة من الحوار الموسع ، ولإعادة التشكيل ، بحيث تحدث عملية عبور سليمة ، لا أن يـُقاد لوضع علني تبقى فيه معظم الأوراق لدى الجهاز الحكومي .
وفي قلب الجمهور التقدمي البحريني خلال عقود من النضال السري البطولي كان هناك رفضٌ لأي تلاعب بهذا التاريخ ، لكن دون جهود لترميم ما انقطع وإعادة تشكيله .
كما أن ذلك ارتبط بوضع دولي معقد انهارت فيه ما سمي بالكتلة الاشتراكية ، لهذا بدت (الماركسية – اللينينية) التي تمسك بها التنظيم كأنها إيديولوجية ملغاة كذلك ، دون أن يقدر على إعادة إنتاجها .
إن المسألة لا تتعلق بجماعةٍ في هذا البلد أو ذاك ، فنصفُ قرنٍ من إنتاجِ الماركسية من قبل المركز السوفيتي ، أو الصيني ، طبعتْ الوعيَّ البشريَّ في العالم الثالث خصوصاً بمجموعةٍ من الآراء القوية التي لا تقبل التغيير ، وغدتْ هذه الطبعة الفولاذية من الماركسية غيرِ قادرةٍ على خلقِ طبعة ثانية فما بالك بثالثة ورابعة .
وأُعتبر خلال السنوات الطويلة السابقة إن أي تحوير في هذه الطبعة بمثابة خيانة ، تستوجب في البلدان المصدرة لهذه الماركسية حكم الإعدام ، ويعتبر ذلك ارتداداً عن الولاء المطلق للبروليتاريا وثورتها التي ستقود إلى انتهاء الطبقات وحدوث الجنة الشيوعية الأرضية.
وحين انقلبت تلك البلدان في عواصمها على هذه الطبعة الأولى من الماركسية مرتدة إلى نقيضها ، حيث الولاء الكلي للرأسمالية ، أصيب المقلدون لها والمتبركون بمقدساتها وبركاتها ، بما يشبه اللوثة السياسية ، التي أضيفت لما قاسوه من قمع واضطهاد ونفي وعذابات.
لكن أحزاباً تقدمية عربية أصيبت بما أصبنا به ، بل وعانت أكثر مما عانيناه ، لم تركض مثل هذه الركضة ، وتتخلى عن اسمها ومأثورها السياسي بمثل هذه الطريقة ، وقامت بالمراجعات في ظل بنائها السياسي ، وعبر التطور التدريجي ، مُصعدة العناصر والقوى التي بقيت خلال النضال ، مما أتاح مراكمة الخبرة السياسية والفكر النظري ، والحفر في الواقع وليس تحويل التنظيم للدردشة .
إن انهاء جبهة التحرير الوطني كتنظيم بذلك الشكل المرتجل ، لا يعني بأية حال انتهاء الفكر الماركسي البحريني ، فليست الجبهة سوى (شكل) من أشكال تجسده الوطني ، وهو شكلٌ اتسم بالبدائية ، ولكنه عكس نضالية متراكمة طويلة ، وهذا الشكل تم تحطيمه بالضربات المتلاحقة في الداخل ، وبعدم عمق القيادة في الخارج ثم تبعيتها للتنظيمات القوموية والدينية ، ولم تقم بدرس التجربة وإعادة النظر فيها من أجل أشكال جديدة ، فوعيها لم يكن يسمح بذلك ، كما أنها تعبت ، مثلما تعبت القواعد في الداخل من السجون .
ورغم اليافطة المسماة (الماركسية – اللينينية) التي رفعتها الجبهة ، والتي كانت فيها نواة وعي موضوعي هام ، إلا أن خططها الحقيقية على الأرض كانت النضال الوطني من أجل (التحرير) والتقدم الاجتماعي البسيط المتاح في ظل تخلف كبير داخلي وإقليمي وعربي ، وتنظيم العمال من أجل نقابات الخ..
هذا الخط الأساسي الصائب العملي الذي تمسكتْ به جبهة التحرير انقذ الكثير من تاريخها من المزايدات وعمق صلتها بالواقع الحقيقي ، ودفعها لتطوير نضالية العمال من أجل حقوقهم وتغيير ظروفهم ، ودفعهم للنضال الديمقراطي العام من أجل الدستور والبرلمان كما حدث ذلك منذ بداية السبعينيات ، وكانت ثورة مارس 1965 حدثاً انعطافياً لهدم الاستعمار وللدخول في تاريخ الدولة المستقلة .
وإذا كانت الجبهة واصلت خط التحدي الكلي للنظام منذ حل البرلمان في 1975 ، دون أن تعثر على استراتيجية جديدة تعي بها المتغيرات الكبيرة الكثيرة في الوضع الداخلي والعالمي ، فإن أحداث التسعينيات ومرحلة الميثاق ، التي كلها جاءت في زمن انتهاء الاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية ، وتحول الولايات المتحدة كقطب مهيمن ، وقبول الأنظمة الملكية العربية بتحولات سياسية معينة ، تظل مهيمنة فيها ولكنها تفسح بعض الهامش لقوى المعارضة ، فإن كل هذه التحولات تستدعي من تيار جبهة التحرير الوطني ، ومن التيار الماركسي عموماً بمجموعاته المتعددة ، طرق جديدة في التفكير ، لا تقطع من خلالها جسورها مع ماضيها ولا تؤبد هذا الماضي في صيغة متحجرة كذلك .
فلا يجب أن نعتبر ما حدث من حل فوضوي للجبهة شيئاً صحيحاً ، ولا يجب أن نعتبر إن المتغيرات السياسية الميثاقية هي شيء أبدي ، بل علينا أن نمازج بين الحفاظ على الماضي وتغيير الراهن السياسي ، الذي يحجمنا ويريد تذويبنا في خطط نجهل مصائرها التالية ، ولكننا نلاحظ خطوط شموليتها في عظام النظام السياسي الراهن .
فهو يعمل للتخلص من المعارضة الدينية الشيعية بدرجة أساسية ، مستخدماً في ذلك تكتيكات عديدة ، ووسائل كلها موجهة للانتصار على هذا (الخصم) وخلخلته ، حتى يسيطر على الساحة السياسية كلها ، مقدماً الفتات السياسي والاقتصادي الذي لا يلغي تحكمه . ولكن ندري بعد ذلك ماذا سيفعل بنا ؟ !
ومن هنا وجب أن لا نتخلى عن ثوابتنا ، فنحن نسينا مشيتنا القديمة دون أن نتعلم المشية الجديدة ، فاحترنا وضعنا .
إن على التيارات الضبابية المتشكلة أن تصل إلى عمق واستقرار فكري ، بحيث تتقارب وتشكل بنية سياسية قوية .
وهذه مسألة حيوية لا بد من مناقشتها ، فقد ظهر خطان أساسيان في التيار الماركسي ، الخط الأول هو خط الماركسية – اللينينية السابق الذكر ، والمواصل للماضي ، والذي يرى تجربة الاتحاد السوفيتي كتجربة اشتراكية مقدسة تمت خيانتها وأن عليه مواصلة هذا الخط حتى الانتصار الكلي للطبقة العاملة وإقامة اشتراكية الخ..
ويمكن أن يتمازج أو يتقاطع هذا الخط مع التجارب الدينية والقومية الشمولية ، أحياناً بشكل متعاونٍ معها ، وأحياناً بشكل متقاطع رافض حاد لها .
في حالة التعاون فإن هذا الخط يمالئ الجماعات الدينية الشمولية وينحاز لصعود المعارض منها ، وهذا يتجلى في التنسيق والتبعية لهيمنة القطب الديني ، وبعدم التعرض لاستبداده في مجالات : شكل التنظيم الطائفي ، وهو شكلٌ خطيرٌ على تطور البلد والناس ، كما أنه يقود إلى تحكم التنظيم الطائفي المحافظ على أوضاع العمال والنساء والأطفال ، لكي يؤبد بقاءه ويتناسل سياسياً إلى أبد الآبدين ، كما لا يتعرض لإيديولوجيته المذهبية السياسية الدكتاتورية هي الأخرى ، كاشفاً أبعادها للجمهور .
وبهذا فإن هذا الاتجاه الديني يعرض ما هو ديمقراطي على المستوى البعيد للخطر ، ويقوم الوعي (الماركسي – اللينيني) المفترض بالتقاطع الجزئي مع ذلك الوعي المذهبي ، إذا جاءت الأمور بشكل صارخ في أوضاع النساء أو الحريات الفكرية دون أن يعارضه بعمق وعلى مستوى شامل ، فيُفترض بناء وجهة نظر متماسكة عامة ، تنطلقُ بدءاً وأساساً من البعد السياسي ، لا أن تجعل البعد السياسي مُغيبـَّاً ، لتقفز إلى مسائل جزئية .
أما الاتجاه الماركسي – اللينيني المعادي بشكلٍ صارخ للقوى الدينية ، فهو يسايرُ الاتجاهات الليبرالية الجنينية ، متماهياً مع النظرات الاجتثاثية للأديان ، متصوراً بأن الأديان هي مجرد شعارات فكرية وسياسية وليست بنى اجتماعية راسخة الحضور في تاريخ المنطقة خاصة .
إن الوقوف ضد الوعي المحافظ الديني المعادي للحريات ولتاريخ المسلمين كذلك ، ضرورة أساسية من ضرورات النضال الديمقراطي ، ولكن لا يعني ذلك فرض تصورات فوقية على الجمهور ، وخلق استبداد باسم التحديث ، بل لا بد من تطور الحريات والتحديث من خلال إرادة الناس ، ومن تطور الفقه والنظرات الدينية العقلانية ومن الصراع ضد الأفكار المحافظة ومن التركيز على تطور الأوضاع المعيشية ونمو حريات العمال والمنتجين .
ولهذا كله فإن الاتجاه (الاشتراكي الديمقراطي) ، أي الخط القابل بالديمقراطية في الحركة الماركسية ، هو الاتجاه المتجاوز لعبادة الأفراد وعبادة الشعارات القديمة ، ومن الأفكار القديمة الاستبدادية سواء كانت في الدين أو في القومية أو في الماركسية .
لكن لا يعني ذلك بأن الاتجاه الاشتراكي الديمقراطي لا يتعايش مع الماركسية حتى بصورتها القديمة ، فالاتجاهان يتفقان على التعبير عن حركة الطبقة العاملة ، ومن يريد التعبير عن البرجوازية أو البرجوازية الصغيرة فلديه تنظيماتها وتياراتها يذهب إليها ، وليترك تنظيم الطبقة العاملة ، الذي قد لا يتفق مع نمط حياته وسياقات أفكاره .
ومن هنا وفي هذه المرحلة الانتقالية يغدو التعايش والتلاقح بين الأفكار المعبرة عن الشغيلة ، ضرورة هامة ، مثلما أن هذا الاتجاه ككل يسعى لتشكيل جبهة ديمقراطية واسعة من القوى السياسية البحرينية بهدف نقل التجربة (الإصلاحية) من نمطها الشمولي الغائر إلى تجربة ديمقراطية حقيقية .
ومن هنا كذلك ضرورة الحفاظ على هذا الشكل التنظيمي العابر من تاريخ جبهة التحرير الوطني حتى تنتهي المرحلة الانتقالية إلى تلك اللحظة من ظهور الديمقراطية الحقيقية .
والمهمات متداخلة ومتآزرة ، فنظام سياسي يقوم على الثوابت الدينية المحافظة ، ويستهدف احتواء مذهب ديني ، وتغيير التركيبة الديمغرافية للمواطنين ، عبر التجنيس الواسع ، وعبر إحلال العمالة الأجنبية بكثافة مكان المواطنين ، وعبر الارتباط بالعالم المحافظ الغربي ، ويتكرس ذلك دستورياً في مجلسين تائهين عن صياغة مشروعات تحويلية جذرية ، إن هذا كله وغيره يتطلب تنامي وحدة القوى اليسارية والشعبية عموماً من أجل تجاوز الصيغة السياسية الراهنة .
لكن التعايش لا يعني التذويب
#جبهة_التحرير_الوطني+البحرينية
#المنبر_التقدمي
__ATA.cmd.push(function() { __ATA.initDynamicSlot({ id: 'atatags-26942-61b2be40b0226', location: 120, formFactor: '001', label: { text: 'الإعلانات', }, creative: { reportAd: { text: 'الإبلاغ عن هذا الإعلان', }, privacySettings: { text: 'الخصوصية', onClick: function() { window.__tcfapi && window.__tcfapi( 'showUi' ); }, } } }); });December 4, 2021
عبـــــــدالله خلــــــــيفة : رأس الحسين
تنزيل رواية رأس الحسين

【رأس الحسين/ أسئلة التاريخ … أسئلة الدم】
د. عزالدين جلاوجي✼
تمهيد:
دراسة الرواية التاريخية تقتضي حزمة من الأسئلة أهمها: ما التاريخ؟ وما الرواية؟ وما مجال كل منهما، ثم ما الرواية التاريخية بالأساس؟
ويمكن أن نطمئن إلى تعريف التاريخ وتعاريفه كثيرة كالتالي: التاريخ هو علم دراسة الحادثة التاريخية، والحادثة التاريخية هي الحادثة الإنسانية الاجتماعية الماضية المفردة ذات المعنى، ونحن هنا مضطرون أن نضع خطوطا تحت كلمات معينة هي: علم، حادثة إنسانية، حادثة اجتماعية، ماضية، مفردة، ذات معنى.
وهي نقاط لا شك تبعدنا عن الرواية التي هي (جنس ينفلت من تعريف جامع مانع يحيط بخصائصه وذلك لانفتاحها الدائم وقابليتها الشديدة للتغير، وهذا ما ذهب إليه باختين Bakhtine على اعتبار أنها الجنس الوحيد الذي مازال مستمرا في التطور، ولم تكتمل كل ملامحه حتى الآن)(1)، وما ذهبت إليه أيضا مارت روبير Robert Marthe معتبرة الرواية جنسا أدبيا لا قواعد له ولا وازع، مفتوحا على كل الممكنات(2).
ولعل موازنة بسيطة بين مفاتيح التاريخ والرواية يجعل الجمع بينهما مستحيلا، هو نفعي ينبش عن الحقيقة ويسعى لها سعيها بكل أدوات العلم المتاحة، وهي خطاب جمالي ترتاد الخيال، وتحلق في عوالمه التي لا نهاية لها، فالرواية التاريخية يتجاذبها هاجسان أحدهما الأمانة العلمية والآخر مقتضيات الفن الروائي، مما يجعل الجمع بينهما إجرائيا كالجمع بين الماء والنار، رغم أن بوريس إيخنباوم في حديثه عن نظرية النثر يرى (أن الرواية تنحدر من التاريخ ومن قصص الرحلات)(3) ، فما مفهوم الرواية التاريخية؟
الرواية التاريخية Roman historique / المفهوم والنشأة
تبنى الرواية التاريخية حكائيا على التاريخ وتقتات عليه وتتشكل منه وتضيف عليه وتختزل منه وتتصرف فيه، ولكنها ليست تاريخا لانصراف كل لون إلى مهامه المحددة، وهي ليست إعادة كتابة للتاريخ بل إعادة تدوين الماضي على نحو جمالي، إن الماضي هو القاسم المشترك فقد استرعى اهتمام المؤرخ والروائي معا، ولكن كل منهما يذهب إليه بأدواته، ويمكن تشبيه التاريخ بالشجرة العارية الجرداء المعزولة، كون التاريخ يبحث عن الحقيقة واضحة مجردة، ويمكن وصف الرواية التاريخية بالشجرة الملتفة المورقة المثمرة المدثرة بالحشائش والأعشاب والأشجار، كون الأدب يرتاد الغموض ويتزين به، فهو ملحه، وتوابله التي من دونها يفقد رونقه وعبقه، وبالتالي فإن الرواية التاريخية تقوم على (التداخل والمناورة والمجاوزة والاستظلال والتحويل حيث يخرج كل من الواقع والتخييل عن أحديته، ويجتمعان في وهم المرجع)(4).
وهو ما يجمعه جورج لوكاش Georg Lukacs حين يذهب إلى أن الرواية التاريخية هي (تلك التي تثير الحاضر، ويعيشها المعاصرون بوصفها تاريخهم السابق بالذات، فالأهم فيها هو إضفاء حياة شعرية على القوى التاريخية والاجتماعية والإنسانية التي جعلت من خلال مسار طويل حياتنا الراهنة على ما هي عليه)(5) ، واعتبر محمد القاضي التاريخ نصا غائبا في الرواية، على اعتبار أن ما بينهما هو تناص، فالرواية التاريخية (استدعاء لخطاب التاريخ الماضي، لإنشاء خطاب الرواية الراهن)(6).
الرواية/ التاريخ: هاجسا الماضي والحاضر:
إن الرواية التاريخية مهما تعمقت الماضي، وسعت للتوغل في مجاهيله، تبقى دائما مرتبطة بالحاضر لا يمكنها أن تنفلت منه، فهي كالشجرة التي تمد جذورها في أعماق التربة/ التاريخ، لكنها في الآن ذاته تعرش بأفنانها وتمد ظلالها في واقع الناس، مما يجعلنا نعتبر الروائي بحق مؤرخ الحاضر، في مقابل المؤرخ الذي يقوم براوية الماضي، وهو ما أكده لوكاتش بقوله: (إن كاتب الرواية التاريخية لا يلتفت إلى الماضي إلا من خلال قضايا حاضره)(7)، وهذا يقتضي أن يعتمد هذا النوع من الروايات على حقبة تاريخية موثقة تكون مادة للحكي، يملأ الأديب تجاويفها بما أوتي من ملكة التخييل، ويضفي عليها لمساته الفنية والجمالية يعيد الأديب تشكيل هذه المادة تشكيلا فنيا جماليا، شرط أن يمتلك قدرة كبيرة على الحفر بالمرحلة بكل أبعادها الاجتماعية والأنثربولوجية.
نشأت الرواية التاريخية من رحم الرواية، ولا يمكننا بأي حال من الأحوال كما يقول نضال محمد الشمالي في كتابه الرواية والتاريخ (تسمية بعض الأعمال السردية التراثية كالسير الشعبية… نقطة انطلاق للرواية التاريخية، الرواية التاريخية جنس تال للرواية… تابع لها)(8)، ويكاد الدارسون يجمعون على أن ولتر سكوت Walter (1771–1832) في روايته ويفرلي 1814 ، يعد أب الرواية التاريخية، وهو ما يؤكده محمد القاضي بقوله: (لم تظهر الرواية التاريخية في الغرب بمعناها الاصطلاحي إلا مطلع القرن التاسع عشر، مع ولتر سكوت (1771-1832) والذي وفق في الجمع بين الشخصيات الواقعية والشخصيات المتخيلة، وأحلها في إطار واقعي، وجعلها تتحرك في ضوء أحداث كبرى)(9) ، ثم ظهرت بعده تجارب مختلفة أهمها، الكاتب الروسي ليو تولستوي Leo Tolstoy (1828–1910) ، والكاتب الأمريكي ستيفن كرين Stephen crane 1900) (1871– ، وغيرهما.
ورغم أن العرب قد عرفوا في القديم روايات شعبية كثيرة كسيرة سيف بن ذي يزن، وعنترة، ، وبني هلال والجازية، وأيام العرب في الجاهلية والإسلام، غير أنه ما كانت الأساس في كتابة الرواية التاريخية عندهم، كون الرواية العربية الحديثة جاءت عبر التأثر بالثقافة الغربية.
وفي العصر الحديث تعتبر زنوبيا لسليم البستاني وقد صدرت سنة 1871 أول نص روائي تاريخي، تتالت بعدها عشرات النصوص الروائية التي كتبها البستاني ذاته أو ما كتبه جورجي زيدان في سلسلة روايات تاريخ الإسلام بين سنتي 1891-1914، وعلي الجارم، ومحمد فريد أبوحديد، وسعيد العريان، ونجيب محفوظ في عبث الأقدار 1939، رادوبيس 1943، كفاح طيبة 1944، وبعد ارتياد الرواية العربية اتجاهات مختلفة عادت مرة أخرى لتطرق باب التاريخ، على يد رضوى عاشور، جمال الغيطاني، عبد الرحمن منيف، واسيني الأعرج، البشير خريف، عبد الواحد براهم، ربيع جابر، عبدالله خليفة.
ويمكن أن نلحظ اتجاهات مختلفة في الرواية العربية التي تعاملت مع التاريخ، تختلف باختلاف الجرعة التاريخية التي تلقتها، والعلاقة التي يقيمها المرجعي والتخييلي تعالقا وتنافرا، إذا أن بعضها قد رجح التاريخ، ولم تكن الراوية إلى مطية لذلك، كما فعل جورجي زيدان مثلا، وبعضها تعادل فيه كما ظهر في روايات نجيب محفوظ، وثالث امتص المرجعي لحساب المتخيل مسقطا التاريخ على الواقع، ومن ذلك ما كتبه جمال الغيطاني في الزيني بركات، ورضوى عاشور في ثلاثية غرناطة.
فما حظ كل ذلك في كتابات عبدالله خليفة، وخاصة في روايته التي بين أيدينا، رأس الحسين، كيف تعامل الأديب مع التاريخ؟ وإلى أي وجهة يمم وجهه؟ وما الأدوات الفنية التي استعملها؟ هذه وغيرها من الأسئلة هي ما نسعى للإجابة عنه في هذه المقاربة.
رأس الحسين أسئلة التاريخ أسئلة الدم
قبل جس نبض الرواية أرى لزاما التوقف عند محطات من جهد الأديب عبدالله خليفة، رغبة في إضاءة بعض من جوانب حياته للمتلقين.
عبدالله خليفة كاتب وأديب بحريني كبير، ولد عام 1948، كتب في القصة والرواية والمقالة وله إسهامات فكرية كبيرة، توفي رحمه الله سنة 2014، عن عمر ناهز 66 عاما.
العتبة الكبرى / الرأس الهاجس:
اعتبر رأس الحسين هاجسا كبيرا في كل التاريخ العربي الإسلامي، على اعتبار أنه منارة للنضال والتضحية، وعلى اعتبار أنه الرمز الأكبر لمنهج النبوة، غير محصور في منهج جده عليه السلام فحسب، بل هو منهج النبوة منذ أن اصطفاها الله تعالى، وهو منهج محفوف بالتضحية وتقديم القرابين.
والمتلمس اليوم بحثا عن هذا الرأس لا يجد ركازها في مكان بعينه، بل ركزتها الأمة في كل مكان، وأقامت لها مقاما كريما في كل مَصر لتكون علما على علم، نجدها في العراق والشام ومصر.
بل إن المتتبع لتبني الأسماء يجد طغيان الحسين والحسن وعلي، في واقعنا الاجتماعي منذ الفتنة الكبرى إلى يوم الناس هذا، ولا نكاد نسمع اسم معاوية ويزيد إلا ما ندر، إنه انتقام بشكل ما، بل بشكل فضيع، كأنما هو سعي لمحوهما من الذاكرة تماما، في حين تحولت الأسماء الأولى إلى أعلام حملها الخلف ويحملها السلف إلى نهاية التاريخ.
مثلت لفظة الحسين داخل الرواية هاجسا مركزيا تحولت معها إلى تيمة رئيسية، حيث ترددت مئتي مرة بل وأصرت على الحضور بداية من العنوان، الذي يعد (عنصرا من أهم العناصر المكونة للمؤلف الأدبي، ومكونا داخليا يشكل قيمة دلالية عند الدارس، حيث يمكن اعتباره ممثلا لسلطة النص وواجهته الإعلامية)(10)، إن ظهور الكلمة التيمة في العتبة يعطيها وقعا أشد وتأثيرا أقوى، ويمنحها السيادة والسيطرة والأولوية، ويمكن أن نسميها الكلمة العمدة على قياس العمدة لدى النحاة، إن (الكلمة/ العنوان… لها محمول استثنائي)(11)، وقد وردت في الرواية عمدة مرفوعة في تركيب الجملة، معرفة بإضافتها للحسين، وهي إضافة تمنحها تميزها ومكانتها وقيمتها، كان للروائي أن يعنون نصه بلفظة الرأس، إلا أن التعريف بالــــ هنا يحيطها بهالة من الغموض ويمنحنا فرصة تأويها ونسبتها، غير أن الروائي منذ الوهلة الأولى قطع علينا ذلك الطريق وكفانا جهد التأويل حين ربطها بالحسين، الذي بقدر ما يحيل عليه في ثقافتنا وتاريخنا، فهو يحيل أيضا على الحس والحسن والحي والحَيْن/ المحنة، وما شئت من المعاني في لغة العرب، والتي اكتنز بها هذا الاسم.
ولا يكتفي الكاتب بالعنوان، بل نرى حضور كلمة الرأس مباشرة في الجملة الأولى من النص، كأنما هو في عجلة من أمره كي يثبتها في الأذهان «انتزعتْ يداهُ الرأسَ»(12)، جملة تفوه بها الشمر وهو يفصل رأس الحسين عن جسده، وتتدافع إليه الأيدي الآثمة رغبة في الظفر بالرأس للظفر بعرض الدنيا، فيعاود الشمر الصراخ في الجميع «أنا الذي قتلته ولي هذا الرأس الثمين!» (13) .
غير أن الدم يتحول نافورة، ويجري موجا هادرا يثير الحيرة والأسئلة، هي بالأساس أسئلة التاريخ وأسئلة الدم، في أول سؤال يستيقظ الضمير على لسان حمزة، وهو الشخصية التي خلقها عبدالله خليفة لتمثل صوت الضمير، صوت الأمة التي أراد حكامها أن يقزموا وضيفتها في التهريج، ولكنه سؤال يحمل إدانة كبرى للحكام/ حكام بني أمية بالأساس «لماذا ساقنا الخليفة يزيد إلى هذه الأرض الترابية والإحاطة بهذه العائلة الصغيرة والجماعة الضئيلة؟! هذه الأسرة التي حاصرناها طويلا وهي لا تستحق كل هذا الحصار العنيف!»(14)، عبارة قصيرة تعتلي صهوة النص وتشرق في طليعته لكنها تفصح عن كل شيء، عن الإدانة كما أسلفنا، «لماذا ساقنا الخليفة يزيد إلى هذه الأرض الترابية»(15)، عن الكبرياء في العترة الطاهرة، التي لم يدفعها ضعفها العددي وقلة حيلتها إلى الاستسلام «بهذه العائلة الصغيرة والجماعة الضئيلة؟! هذه الأسرة التي حاصرناها طويلا وهي لا تستحق كل هذا الحصار العنيف»(16)، عن تأنيب الضمير الذي تحيل كلمة «لا تستحق»(17).
وفجأة يتحول التأنيب إلى حيرة حين تنتقل الأحداث من الواقع إلى الغرائبي والعجائبي، وحين تختفي الجثث فجأة، ولا يجد حمزة مناصا من أن يقلب طرفه حائرا في كل مكان «أين ذهب الضحايا؟»(18) «أين رحل القتلى؟»(19) سماهم ضحايا في جملته الأولى، وسماهم قتلى في الثانية، لكنه لم يجرؤ أن يصفهم بالموتى، فالشهداء يقتلون ولكن لا يموتون، والصالحون يقدمون أنفسهم قرابين لله تعالى ليخلدوا عنده، وهذا يحيلنا على إبراهيم عليه السلام وهو يقدم ابنه، فهل هي إشارة للتماثل في بيت النبوة بين إسماعيل والحسين
عليهما السلام؟ وهو تناص واضح مع قوله تعالى «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون»(20).
ويذهب الخيال بحمزة حين يتصور أن الموتى قد مضوا سريعا إلى السماء مستعيرين أجنحة، كأجنحة الطيور، «قد مضوا بسرعة، أو أن أرواحهم استعارت أجنحة الطيور واندفعت في السماء تشكو، وأن سهاما من النور والنار سوف تتدفقُ من العلياء وتثقب جلودهم!»(21)، وهو ما يحيل مباشرة على قصة جعفر الطيار عليه السلام.
إذن هي جملة من الأسئلة يستهل النص بها حضوره، قدمت منذ البداية تصورا عاما للمنحى الذي ستأخذه مئات الأسئلة التي ستأخذ برقاب بعضها إلى نهاية نص الرواية يكون محوراها الأساسيان، الحسين مجللا بنور الحق، ويزيد مكبلا بأغلال الباطل.
تتناوب الرواية مجموعة من الشخصيات كلها ذات صلة بالتاريخ، إلا شخصية حمزة الذي كان مهرجا بالقصر الأموي، ثم يغامر للحصول على رأس الحسين دون سيف يحمله، طمعا في أن ينال بذلك قسطا من المال يبني به مستقبله، وتنتهي به الرواية ثائرا ضد الظلم الأموي منتصرا لحق آل البيت، وهو بذلك يمثل الضمير الجمعي للأمة التي أراد يزيد أن يجعل منها قاراقوزات في قصره، فشحذها الحسين بطاقة خلاقة لتنتفض ضد الظلم، ليس في تلك الحقبة فحسب، بل في كل ما تلاها وما يليها من حقب.
غير أن الرواية كلها تقوم على شخصيتين محوريتين، الشخصية الأولى وهي الحسين ولا يمثلها داخل الرواية كلها إلا رأسه، الذي تتناوبه الحراب والأيدي الآثمة من كربلاء إلى دمشق، والثانية هي شخصية يزيد التي لا تبرح قصر الخلافة، وفيما يلي بسط لحضورهما داخل الرواية.
1ـــ رأس الحسين/ منارة فوق رمح:
تنطلق أحداث الرواية مباشرة من قتل الحسين عليه السلام وقطع رأسه، ومعنى ذلك أن الروائي يضرب صفحا عن كل ما سبق هذه الحادثة من أحداث فصلت فيها كتب التاريخ، بل ويضرب صفحا حتى عن جسد الحسين، «يا سيدي الجثة لم نعثر لها على أثر، كأنها سرقت، أو خطفها أشباح أو جن أو بشر، فجأة توارت في الظلام..!»(22).
على اعتبار أن الحسين ليس جسدا بقدر ما هو رأس/ فكرة، ولم يفعل الموكب الآثم وهو يتحرك بالرأس مرفوعة على رمح طويل سوى أن يجعل منها راية ستبقى مرفرفة ترسم الدرب للصادقين في تلمس شمس الحق «حدق جعدة بغضب في راية الشمر حيث كانت الرأس مرفوعة على الرمح، والشمر يزهو بقوته ورمحه الذي يحمل الجائزة الكبرى!»(23).
وما تكاد العصابة تتحرك حتى ينتقل بنا الكاتب من عالم الواقع/ التاريخ إلى العالم العجائبي، حين يبث الروح في الرأس، فإذا بها تنظر وتبتسم «والتفت فوجد رأس الحسين تنظرُ إليه وتبتسم!»(24)، بل وتتكلم «الجثة التي بلا رأس تتكلم»(25)، ورغم أن الرأس كانت تحاور حمزة بالأساس، «هل تعرف يا شمر بأن الرأس تكلمني، هذه التي تحملها على رمحك القاسية تشير إلي بعينيها وثمة نورٌ غريب يتدفق منها!»(26) مما يجعله خائفا مضطربا طول الطريق بين كربلاء ودمشق، فإن ذلك ينتقل إلى غيره من المقاتلين، حتى الشمر الذي لاحظ اضطراب حمزة فسعى لمعرفة الحقيقة منه، يقول حمزة للشمر: «غريبة هذه الأمور، لأن أفرادا من الجيش صاروا يسمعون هذه الرأس وهي تتكلم، بعد أن حاصرتها يا شمر وقطعت الماء عنها وأطلقت عليها كل هذه السهام وطعنتها بكل السيوف لا تزال تتكلم، وتحدث الجنودَ والناس…»(27).
يتعجب الشمر لما يسمع وعجل يتفقد الأمر «أوقف الحصان وأنزل الرمح وقرب الرأس الملفوفة بالقماش، وطالع الوجه المفتوح، وكان الغبار وكانت ظلمة كبيرة مفاجئة، وكانت صرخة من الشمر ، الذي أسقط الرأس وهو فزع، صرخ: كأن شيئا عضني!»(28).
لاشك أن ما وقع فيه الشمر كان بفعل إحساسه العميق بما ارتكبه ضد الحسين، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تصير الرأس أفعى، غير أن وهم الشمر وقناعته بجرمه أوقعه في ذلك، وتوهم هذه العضة المؤلمة، وهو مما بقي في ضميرنا الجمعي إلى اليوم، الإحساس بالذنب الذي آلم أولئك الذين ارتكبوا الجريمة أو سكتوا عنها في حينها، انتقل إلى أحفادهم الذين ظلوا بطرق مختلفة يسعون إلى التطهر.
كان يمكن للكاتب انطلاقا من مأساة الحسين أن يجعلها باكية شاكية، شاتمة لاعنة، محرضة على العنف والانتقام، عبر تحريض الناس، لكن ذلك كله لم يحدث، إنها رأس شامخة مكابرة هازئة من الجرح، لا تحسن إلا أن تنشر المحبة والسلام، تحاصر الحقد بالحب، والضغينة بالتسامح، والغضب بالابتسام، تمد سنا الحلم حتى يضيق بحلمها السفهاء.
وما تكاد الرأس تدخل قصر الخلافة في دمشق حتى تزلزل أركان الخليفة يزيد، «لا أحد معي في هذا القصر الكبير. أريد صديقا وأنتم لستم أصدقاء. أنتم تكرهون هذه العائلة كلها،… والرأسُ التي حملوها إلي هنا تشع دما ، وتأتي إلي في رقودي الصعب، الحسين يتطلعُ فيّ ويسخرُ مني.. إنني لا أستطيع أن أكون في مكان واحد معه. أقول له أصفح عني، ولكنه يتطلع إلي ويضحك! أحاول أن أبعد رأسي دون فائدة، أغطي عيني بالظلمات الكثيفة فأراه يشعُ فيها..» (29).
ولا يملك يزيد إلا أن يأمر بنقلها إلى خيمة لتوضع تحت مرأى الجميع، لا شك أن يزيد كان يسعى أن يتخلص من الرأس أولا، ويجعلها عبرة للجميع ثانيا ليبث فيهم الرعب، غير أن الأمر ينفلت عن السيطرة، حين تتمرد الرأس على كل القيود والسجون وتنزرع في عيون الأطفال، وأحلام الكادحين، وحناجر الطيور، ونسمات الربيع، وسلاسل المسجونين، إنها كبرياء تعلمنا جميعا كيف نحيى بشرف «ويجثمُ عند الرأسِّ بضعة حرا س أشداء غلاظ، مسلحين بالحديد. والناس تأتي لتحدق… ويدقُ المطرُ بعنف شديد، وتهتز الخيمة ويرتعشُ قماشها بقوة، وتندفع سيوف البرق فجأة وتشعلُ بعض أجزائها، ويطفئ الحراسُ النارَ بصعوبة، وتبدو الخيمة كبهو كبير مفتوح، ويُضاءُ باتساع، فتتضخمُ الرأسُ وتبدو من مسافات بعيدة، فعبر النوافذ الصغيرة الملقاة في بحر الحجر، وعبر الشرفات الكبيرة المفتوحة على الجبل والهواء والطيور، ومن ثقوبِّ الأكواخ، ومن أبواب المقاهي ومن أفواه الأسواق المفتوحة على اتساعها لالتهام الجيوب، ومن نوافذ القصر وأسرة الجواري ومن خرم إبر السجون الكثيرة المنتشرة عبر المدينة.. »(30)، لا شك أن قصة انتقال رأس الحسين من كربلاء إلى دمشق وما صاحبها من أهوال وعجائبية تنقل قصتها من مجال التاريخ والرواية معا إلى مجال الرحلة أيضا، كون عنصري العجيب والغريب يطغيان على رواية الرحلة وتمتزج فيها الحقيقة والخيال، لدرجة يصعب معها الفصل بين الواقع والخيال.(31).
2 ـــ يزيد/ اللعنة الأبدية:
يقدم الكاتب يزيد رجلا ضعيفا مستهترا بكل القيم التي يؤمن بها المجتمع الذي يقوده، حتى قيم الدين ذاته، يغرق في طلب اللذة، تحيط به مئات الجواري وزجاجات الخمر، معتقدا أنها طريقه للهروب من مواجهة حقيقته التي تربى عليها على يد أبيه معاوية «ليس ثمة حل لكآبة ما بعد الشرب سوى الشرب! هيا أضحك ودع هذا التجهم!»(32)، يبحث عن التسلية حتى مع المهرجين والقردة «كان يزيدٌ يلاعبُ قردا. كانت القاعة فسيحة، وبضعة نسوة جالسات على السجاد الملون باللؤلؤ، ويضحكن»(33).
يفتقد ذلك حتى في زوجته، وابنه الذي تمرد عليه وغرق في تبتل دائم مزورا عن نهج الانحراف الذي سار عليه أبوه، لقد اختار يزيد لابنه اسم معاوية ليس في تصوري وفاء لأبيه بقدر ما هو دلالة على ضعفه الذي جعله في حاجة ماسة إلى قوة أبيه وحنكته، لكن الفتى يخيب ظن أبيه، يغرق في بداية حياته في اللهو، حتى إذا ما قتل الحسين يفر إلى عالم التبتل، مناقضا تماما أباه الذي ما كان يؤمن بدين أصلا، ولذلك نراه يسعى بكل ما أوتي من قوة لتتفيه العبادات عنده حتى الصلاة «يدخل يزيد جناح أبنه معاوية الثاني، يراه يصلي، هو راكع الآن، ينحني ليسجد، يمسكه من كتفه: ماذا تفعل يا بني؟ تصلي؟ هيا دع عنك هذه الحركات!»(34)، محاولا أن نَيزج به في عالم المجون «صاح يزيد: لن تخرج من هنا أيها الأحمق. انظروا يا ناس فتى غضٌ يتركُ مخاز الخمور واللحم وغرف الجواري ويريد الذهاب إلى كهف»(35).
ويسعى الكاتب في أن يعري بني أمية جميعا، حين يعتبر حصارهم لآل البيت انتقاما من الرسالة ذاتها التي كانت في بني هاشم ولم تكن فيهم، إذ لم يكن إسلامهم إلا مناورة، يقول يزيد مخاطبا الحسين «منذ زمن بعيد وهذا العرش مكتوبٌ لنا، بعدت الرسالة عنا، لكن الكرسي لا يعرف غيرنا.. منذ المجد الغابر ونحن فرسان الخيل والسياسة والدهاء، وليس لكم يا بني هاشم سوى القراطيس والأحلام!»(36).
غير أن الهاجس الأكبر الذي نكد على يزيد كل حياته، هو رأس الحسين، فهو لم يكن يريد جسدا ولا رأسا، بل كان يريد استسلاما وخضوعا، مقتل الحسن نهاية لعرش يزيد، استشهاد الحسين لعنة صبتها السماء على آل معاوية، “يجلس على المقعد وهو يتنفس بصعوبة، يغمغم: كلُ جهدي ذهب هباءً، كل مطاردتي له، وحصاري العنيد العنيف، وقتل أهله، لم يفد شيئا كنتُ آمر بحصار أهله وقتلهم لكي يتصدع داخليا،… كنتُ أتوقع أن ينهار ويصرخ: ارحمني يا يزيد!… ما باله بهذا العناد والحماقة! لم أكن أريد سوى أن ينحني لي فقط، هل هذا شيء عظيم؟ وفضل الموت.. فضل قطع الرأس بالسيف على أن يقول لي كلمة،… حتى في موته حاول أن يذلني، أن يهينني، أن يبصق في وجهي، يصرخ الآن أنت تافه؟»(37)، والهاجس ذاته يكرره في موقع آخر وهو يلقى قائد جنده عائدا من ساحة المعركة، فيعجل إليه ليعرف شيئا واحدا، الخوف في عيني الحسين «أي مجنون أنت؟ كيف يمكن لرجل لا يخضع لي ولا يؤمن بجبروتي والسيف على رقبته؟ لا يمكن هو جبان، هو جبان وكان يتذلل وينتفض ويرتعد، ويصرخ سوف أخضع ليزيد، قل الحقيقة!»(38).
رواية رأس الحسين/ التاريخ بطعم الأسطورة:
لاحظنا منذ البداية أن الكاتب وإن حافظ على الأحداث الكبرى للتاريخ إلا أنه ازور عنها ليتعمق نفوس الشخصيات، إذ لم يكن الهدف أساسا هو الحادثة التاريخية بقدر ما كان الهدف هو كيف تفاعلت هذه الشخصيات مع الأحداث، وهي شخصيات مثلت كل طبقات المجتمع، الطبقة الحاكمة ممثلة في يزيد وعائلته وبني أمية، طبقة الجند ومثلها الشمر ومن خاض معه مغامرة قتل الحسين للحصول على المال، طبقة العامة من الناس ومثلتها أسرة الشمر وغيرها من أسر القبائل بأطفالها ونسائها وشبابها، الطبقة الثائرة ومثلها آل البيت وعلى رأسهم الحسين وزينب عليهما السلام، ضمير الأمة في تلك السنوات العجاف إلى يوم الناس هذا ومثله حمزة وكل الثائرين معه، بمن فيهم معاوية بن يزيد.
غير أن الكاتب يركز أساسا على شخصية الحسين، بل وعلى الرأس بالذات الذي ينقله من الواقع إلا عالم العجائب لدرجة أسطرته، فالرأس ينظر ويبتسم ويتكلم ويؤثر في واقع الطبيعة، ويختفي تماما كما اختفت الجثة من قبل، ليصير طاقة ثورية خلاقة داخل النفوس، منطلقا من تيمة الموت إن جاز لنا أن نزعم ذلك انطلاقا من تقسيم جان مالينو «Jean Malino» لتيمات العجائبي (الجن والأشباح، الموت ومصاص الدماء، المرأة والحب، الغول، عالم الحلم وعلاقاته مع عالم الحقيقة، والتحولات الطارئة على الفضاء والزمن)(39)، وهذه الطاقة ما كان لها أن تحدث لولا انتقال الكاتب من عالم الواقع إلى عالم الغريب المدهش، أو المعروف في ثقافتنا الدينية بعالم المعجزات والكرامات، أو ما يسميه تودوروف بالكثافة مفرقا بين الواقعي والعجائبي، يقول: (إن ثمة اختلافا في الكثافة التي تبلغ أقصاها في العجائبي)(40).
إن عبدالله خليفة لم يحرص على الحقيقة التاريخية، التي أوردها في كثير من الأحيان متخذا موقفا صريحا صراحة فنية، بل انتقل من حقيقة التاريخ/ المرجع إلى عالم تخييلي صارخ، إنه عالم العجائبي، فهل يمكن أن تصنف الرواية في باب الرواية العجائبية أيضا، على اعتبار أن العجائبي ينشأ عندما يتدخل التخييل في تحويل فكرة منطقية إلى أسطورة(41)، كما يذهب إلى ذلك بيار جورج كاستيكس Pierre-Georges Castex، وعلى اعتبار أن معظم عوالمها تستحضر العجائبي من خلال الرحلة، رحلة رأس الحسين من كربلاء إلى دمشق، كأن الحسين أبى إلا أن يمضي في طريقه حتى يهد عروش الظلمة، فالحسين حق لا يمكن أن يقهره قتل، وفكرة تتمرد على الجسد المادي، وروح تظل تسري في النفوس عزة وكبرياء، ولم يقتصر موضوع العجائبي على الرحلة فحسب، بل إن اختفاء الجثة أولا منذ بداية الرواية «يا سيدي الجثة لم نعثر لها على أثر، كأنها سرقت، أو خطفها أشباح أو جن أو بشر، فجأة توارت في الظلام»(42)، واختفاء الرأس في آخرها «لكن رأس الحسين يا سيدي اختفت..»(43)، ينقل العجائبية إلى موضوع الغيبة، الذي ارتبط في الثقافة الإسلامية بالمهدي المنتظر، وقبله بالنبي عيسى الذي رفعه الله إليه، بل ويرتبط ذلك بالشهداء أيضا الذين يخبرنا القرآن الكريم أنهم يقتلون ولا يموتون بل يظلون أحياء بيننا يرزقون دون أن نحس بوجودهم بيننا، مع الإيمان بعودة هؤلاء جميعا جسدا وروحا وإن لم يغيبوا فكرا من واقع الناس، على اعتبار «إن الجسد ليس كيانا منغلقا على ماديته الخالصة، فهو بناء رمزي يخضع للحالة الاجتماعية وللرؤية للعالم، أي أن الجسد ليس مسكنا أو قبرا أو حاويا فقط، بل هو علامة تتكلم وتشير وتنخرط في تواصلية ذات دلالات»(44).
إن عبدالله خليفة بهذا النزوع نحو العجائبية لا يقصدها بحد ذاتها ولا يرمي للتسلية والمتعة، بقدر ما يرمي إلى جعل رأس الحسين رمزا كبيرا يستمر في واقع الناس اليوم ليتحدوا به القهر والظلم والهزيمة، وهو الذي فعل داخل النص ذاته حين صير حمزة وبعض المسحوقين في واقع الناس آنذاك إلى ثوار.
وهذا الإصرار على المنحى العجائبي داخل النص بوظيفته الرمزية ينقل رأس الحسين من التاريخ/ الماضي، إلى حاضر الناس وواقعهم، بل وإلى مستقبلهم وتطلعاتهم أيضا، وليس الأمر غريبا على كاتب مثقف في حجم عبدالله خليفة الذي ظل في كل ما خط يقف إلى جانب المحرومين والمسحوقين، يبحث لهم عن شعاع من أمل، وعن حلم يتشبثون به بحثا عن كرامتهم وشرفهم.
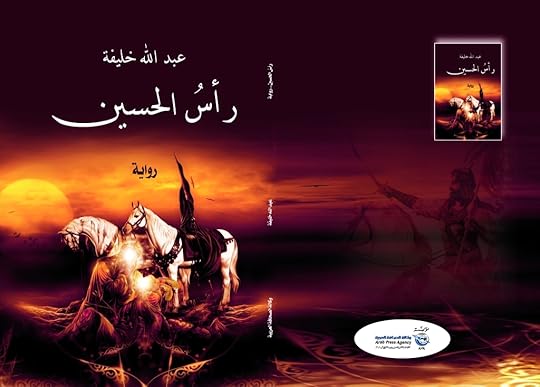
الخاتمة:
يتجلى لنا مما تقدم المراس الكبير الذي يمتلكه الأديب عبدالله خليفة، فهو يختار الحادثة التاريخية الأكثر حضورا لدى عامة الناس، دون أن يقف عند حدود المرجع، وإنما يصبغ عليها عوالم متخيلة تصل بها إلى حد العجائبي، ثم يحينها رابطا إياها بواقع الناس ومستقبلهم، إذ أن الرواية التاريخية تكمن أهميتها في تحويل الخطاب التاريخي النفعي، الملتفت إلى الماضي (خطابا روائيا إبداعيا منشغلا بقضايا الراهن جماليا وأيديولوجيا)(45)، بل ويذهب بيار لويس راي إلى حد اعتبار الرواية التاريخية تغدو أكثر صحة من التاريخ (46).
وبحكم إيمانه القوي بدور الأدب في صناعة الإنسان، فإن الأديب لا يجعل من نصه مطية للفني والجمالي فحسب، لكنه يتجاوزه إلى جعله حاملا لرسالة أيديولوجية عظيمة أساسها حرية الإنسان وكرامته.
وهو لتحقيق ذلك لم يتوان أبدا في استغلال كل الممكنات الإبداعية التي يوفرها السرد، وعلى رأسها هذه الثنائية الضدية التي تجلت على مستوى الشخصيات، وهي بقدر ما فيها من بشارة لانتصار الخير والفضيلة، بقدر ما فيها من تحذير للطبقة المتسلطة التي لا يمكن إلا أن تكون مأساوية وظلامية.
حافظ الأديب على الشخصيات التاريخية كما هي وسار بها كما سارت بها الأقدار، خير أنه صنع لنفسه شخصية «حمزة» فحملت كل الرسالة التي أراد الكاتب أن يبلغها لنا، حمزة الذي كان في قصر السلطة مجرد مهرج، يتحول إلى قائد للثائرين ضد هذا القصر، وما كان لحمزة في بعده التاريخي واللغوي من معاني القوة والتحدي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✲ استاذ جامعي من الجزائر
الهوامش:
1- مجموعة من المؤلفين، معجم السرديات، دار محمد علي، تونس، 2010 ، ص 202 .
2 – المرجع نفسه، ص 202 .
3 – محمد القاضي، الرواية والتاريخ، الرواية والتاريخ دراسات في تخييل المرجعي، دار المعرفة، تونس، 2008 ، ص 220
4- المرجع نفسه، ص 23 .
5 – المرجع نفسه، ص 80 .
6 – المرجع نفسه، ص 23 .
7 – مجموعة من المؤلفين، معجم السرديات، ص 211 .
8 – نضال الشمالي، الرواية التاريخية، بحث في مستويات الخطاب في الرواية التاريخية العربية، ط 1 ، عالم الكتب الحديث، الأردن، 2006 ، ص 111 .
9 – محمد القاض ي، الرواية والتاريخ، ص 24 .
10- شعيب حليفي، هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، 2004 ، ص 9 .
11 – يوسف وغليس ي، التحليل الموضوعاتي للخطاب الشعري، كلام المنهج.. فعل الكلام، دار ريحانة للكتاب، الجزائر، 2007 ، ص 52 .
12 – عبد الله خليفة، رأس الحسين، دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر، 2012 ، ص 5 .
13 – المصدر ص 5 .
14 – المصدر ص 5 .
15 – المصدر ص 05 .
16 – المصدر ص 5 .
17 – المصدر ص 5 .
18 – المصدر ص 6 .
19 – المصدر ص 5 .
20- سورة آل عمران 169 .
21- المصدر ص 6 .
22 – المصدر ص 33 .
23 – المصدر ص 26 .
24 – المصدر ص 26
25 – المصدر ص 9 .
26- المصدر ص 48 .
27 – المصدر ص 50 .
28 – المصدر ص 51 .
29 – المصدر ص 123 .
30- المصدر ، ص 147
31- العربي إسماعیل، دور المسلمين في تقدم الجغرافیا الوصفیة والفلكیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1994 ، ص 11 .
32 – المصدر ص 44 .
33 – المصدر ص 29 .
34 – المصدر ص 43 .
35 – المصدر ص 66 .
36- المصدر ص 127 .
37 – المصدر ص 32
38- المصدر ص 30 .
39 – شعيب حليفي :شعرية الرواية الفانتاستيكية، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، ط 1،1997 ، ص 25 .
40 – حسين علام، العجائبي في الأدب من منظور شعرية السرد، ص 200 .
41 – : Anthologie du conte fantastique français , Librairie José corti, Paris, 2004, p.5 Georges Castex-Pierre / نقلا عن الخامسة علاوي، العجائبية في أدب الرحلات،
رحلة ابن فضلان نموذجا، دار السويدي للنشر والتوزيع، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 2011 ، ص 46 .
42 – المصدر ص 33 .
43 – المصدر ص 185.
44- حسين علام، العجائبي في الأدب من منظور شعرية السرد، ص 204 .
45 – محمد القاضي، الرواية والتاريخ، ص 178 .
46 – pierre louis ray. le roman hacgette.1992. p 17 نقلا عن محمد القاض ي، الرواية والتاريخ، ص 178
المصادر والمراجع:
1 . حسين علام، العجائبي في الأدب من منظور شعرية السرد، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، 2010 .
2 . الخامسة علاوي، العجائبية في أدب الرحلات، رحلة ابن فضلان نموذجا، دار السويدي للنشر والتوزيع، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 2011 .
3 . عبدالله خليفة، رأس الحسين، دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر، 2012 .
4 . العربي إسماعیل، دور المسلمين في تقدم الجغرافیا الوصفیة والفلكیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1994 .
5 . شعيب حليفي : شعرية الرواية الفانتاستيكية، القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، ط 1 ، 1997 .
6 . شعيب حليفي، هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، 2004 .
7 . مجموعة من المؤلفين، معجم السرديات، دار محمد علي، تونس، 2010 .
8 . محمد القاض ي، الرواية والتاريخ دراسات في تخييل المرجعي، دار المعرفة، تونس، 2008 .
9 . نضال الشمالي، الرواية التاريخية ، بحث في مستويات الخطاب في الرواية التاريخية العربية، ط 1 ، عالم الكتب الحديث،
الأردن، 2006 .
10 . يوسف وغليسي، التحليل الموضوعاتي للخطاب الشعري، كلام المنهج.. فعل الكلام، منشورات دار ريحانة الجزائر، 2007
__ATA.cmd.push(function() { __ATA.initDynamicSlot({ id: 'atatags-26942-61ac30d48b0fd', location: 120, formFactor: '001', label: { text: 'الإعلانات', }, creative: { reportAd: { text: 'الإبلاغ عن هذا الإعلان', }, privacySettings: { text: 'الخصوصية', onClick: function() { window.__tcfapi && window.__tcfapi( 'showUi' ); }, } } }); });December 1, 2021
عبـــــــدالله خلــــــــيفة : الساقطون واللاقطون ــ المنبر اللاتقدمي مثالاً
كل حركة سياسية واجتماعية تصاب بالنمو والتراجع، بالنهوض والتدهور، ليس فقط بسبب أعدائها وخصومها والضربات التى تُوجه إليها فحسب، بل أيضاً بسبب عملية حراك داخلية تجعلها تتفتت أو تقوى، تتحلل أو تتجذر.
وبطبيعة الحال فإن أقسى الضربات هي التي توجه إليها من نشطائها وأعضائها وأخطرها تلك التي تأتي من زعمائها، وعموماً فإن الضربات الداخلية تحطم الروح المعنوية ومصداقية الأفكار التي انبنت عليها الحركة، وتعطي الجمهور المؤمن بها صورة أخرى، تجعله يقلل من رفدها وتعضيدها.
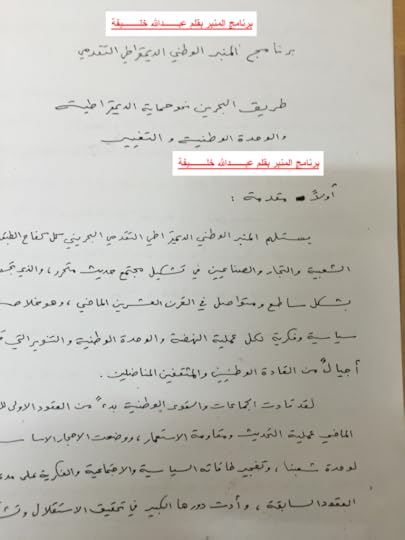
ولهذا فإن الصراع الفكري والروحي هو الأكثر خطورة والأشد فاعلية على الحركات السياسية المتجهة لتغيير الخريطة السياسية والاقتصادية، حيث إنها تقدم رموزاً تصنع أملاً وضوءاً جديداً من لحمها ودمها لجمهور متعطش إلى العدالة ورفع الغين.
فإذا أصبحت هذه الرموز هي الأكثر اهتماماً بمصالحها و ظروفها الشخصية، وراحت تجري نحو المكاسب والمغانم، فإن ضرراً معنوياً كبيراً يلحق بحركة التغيير الاجتماعي، ولا يعود ثمة فرق بين قوى الظلم وقوى العدالة، بين الحرامية والشرطة الاجتماعية، بين الجلادين والضحايا.
وغالباً ما تُدرك آذان الجمهور المدربة على الحس النقدي أي سقطة أو أي ذبول أو تراجع عند رموزها، ويؤدي الانتقال من معسكر إلى آخر إلى صدمة نفسية، وخاصة إذا كان الرمز قد كرس حياته لقضيته، وتحمل الأهوال من أجلها، ثم يقوم بين عشية وضحاها بعبور جبل التضحيات إلى ضفاف قيم أخرى مضادة..
والحال إن إمكانيات البشر على التحمل والتضحيات متباينة، وقدراتهم على الصبر وعلى القبول بالعيش القليل والجوع متفاوتة، والحياة السياسية بتقلباتها العنيفة غالباً ما تعرض هذه الخصال للانكشاف، ولا يستطيع إلا القليلون الصمود في هذه المسيرة الصعبة، في عالم متخلف لا يعرف غير القهر سبيلاً للسياسة.
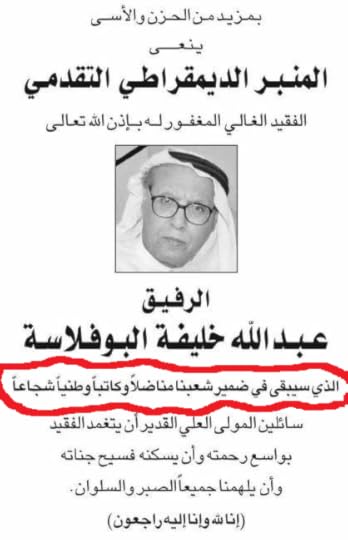
ولهذا فإن مسيرة النضال وعرة، وكثيرأ ما تؤدي الضربات والملاحقات والقمع إلى هجرة الكثيرين من هذا الدرب الصعب، ومن يبقون يواجهون كذلك صعابا أشد.
وبما أن هناك علم الاجتماع الثوري فإن الطبقة المسيطرة تدرسه كذلك وليس فقط المناضلون، وهى تدرك بأن عملية التغيير لها قوانين موضوعية وذاتية، تماماً كما يعرفها الثوريون، والفارق ان القوة المسيطرة تأتي لميدان الكفاح من أجل وقف التغيير، مدعومة بأجهزتها وإعلامييها وأموالها، في حين يأتي المناضلون إلى ساحة التاريخ من أجل التغيير، وليس لديهم سوى الناس ومصداقيتهم السياسية!
ولهذا فإن القوة المسيطرة تدرك أن أهم أسلحتها هي تفتيت التغيير عبر شراء الرموز، وشراء رمز وتفتيت حركة وهدم حزب من الداخل، هو أكثر تأثيراً وأشد مضاءً من اعتقال المئات وقتل الآلاف.
إن شراء رمز لن يكلف نظاما ما سوى القليل، ولكن تأثيره المعنوي كبير، والحرب النفسية التي تعقبه أشد من الحبس، بحيث تجعل الجمهور يضطرب وتتدهور معنوياته، وتؤدي أي ضربة أخرى فيه إلى هزيمته.
وعمليات إضعاف الرموز وتدمير صورتها وحرقها سياسياً، هي من أخطر العمليات السياسية التي تدرسها الأنظمة، وترتبك في رؤيتها التنظيمات السياسية، نظراً لتداخل الأدوار وخلط الأوراق!
وهكذا فإن كل حركة سياسية شهدت مناضلين انضموا إلى الأنظمة التي حاربوها، بل إن أفضل الكوادر قد جاءت من الحركات المعارضة غالباً، فهي التي تمد النظام، أي نظام، بعيونه وموظفيه وكوادره الثقافية والنظرية!
إن هؤلاء المتحولين من ضفة الى أخرى، هم الذين ركزت عليهم قوى النظام، نظراً لصراعهم معها، ودراستها لهم، وتثمينها لخبراتهم، واحتياجها لأدوارهم في ضفتها.
فهي تدرس ظروفهم واحتياجاتهم وتصغي لأحلامهم وتعرف نقاط ضعفهم وقوتهم، وهكذا فإن الصراع السياسي ليس لعبة، بل علماً دقيقاً معقداً ترفده علومٌ وعيون من التقصي والبحث والفعل.
أدرك أجدادنا القدامى ظروف النضال الصعبة في المنطقة وفي عوالم الاستبداد الشرقي، ووضعوا للمناضل وصفات تتلخص فى الزهد الشديد وإنكار الذات الكبير والتضحية وفهم العلوم، وهي وصفات استمرت في تاريخ الحركات السياسية القديمة وحتى الحركات السياسية المعاصرة من دينية وقومية وماركسية، على اختلاف رؤاها، ومدى تطبيقاتها.
ولهذا كان تاريخ النضال في الشرق مرتسماً بصورة النبى والزاهد والمتصوف، لمواحهة إغراء القوى المتنقذة الغنية والباذخة.

فالحركات السياسية المعارضة تقوم بتنمية أفراد ما وتدربهم وتصقلهم، وهذا كله يتم بتضحيات جسام، فلا يظهر المناضل نبتاً في البرية، بل تسقيه دموع ودماء، وينبت لحمه السياسي من تبرعات الفقراء واشتراكات الأعضاء، ويكبر بين غارات الشرطة وعذاب الآباء والأمهات، ولهذا لا يعد المناضل ملكاً لشخصه، وحين يصير زعيماً فإن شعباً بأكمله يكون قد استثمر فيه رأسماله الروحي.
ولهذا تغدو كارثة حين ينتقل هذا الرأسمال النضالي من ضفة إلى ضفة معادية، فبدلاً من أن يثمر الألم والدم الشعبي يصير أشواكاً وخناجر.
ولهذا من الكوارث أن يفرط شعب ما في زعيم وطني بسبب سوء فهم، أو اختلاف في الرؤى أو تباين في الوسائل.
إن الانظمة عادة تقودها وسائلها وعمليات استغلالها إلى فقدانها للكوادر المخلصة، ويتدفق عليها الانتهازيون من كل حدب وصوب، وهؤلاء فوائدهم قليلة، وانقلابهم عليها يتحقق بلمح البصر، ولهذا فإنها تعد المناضلين صيدها السمين، فكلما انهار فصيل والتحق بها، شعرت بالقوة، وتجد إن عنفها يحول الكثيرين من المناضلين غير الصبورين والمذعورين والتافهين إليها. فتحول فقرها الفكري والسياسي إلى قوة.
في الأنظمة اللاديمقراطية والتى لاتزال تعيش صراع الغالب والمغلوب، تفضل الأحزاب الدينية أن تموه خطاباتها السياسية عبر الدين، لأن التحول المفاجئ إلى غنائم السلطة، يمكن تبريره بآراء واقتطافات من الدين تبعد مسئولية الزعماء عن عمليات التسلق السياسي وتربطها بالغيب وبالتالي تبعد المحاسبة الحزبية والشعبية عنها.
ولهذا تحاول الأنظمة أن تجعل الكوادر الحزبية العريقة جزءً من استثمارها السياسي، عبر الإغراءات المادية والمعنوية، بحيث يتحول هؤلاء الذين شكلهم الشعب بشكل غير مباشر. الى خدمة السلطات التي لم تسهم في خلقهم بشيء، بل اضطهدتهم في سنين سابقة.
فالذين لم تغرهم المظاهر المادية يمكن رشوتهم بمنصب علمي أو ثقافي، وبالتالي تتسلل إليهم عملية الانفصال عن النقد والاعتراض، ويصيرون حزءاً من الآلة السياسية.
وبطبيعة الحال فإن الاشتراك في المناصب والحكومات هو شيء ضروري للتطور، لكن بحيث يكون جزءاً من اتفاق بين قوى سياسية وليس بين قوة سياسية مهيمنة وأفراد، يبدأون بالتخلي عن انتقاداتهم واستقلالهم الفكري والسياسي، وبالتالي يفقدون ثمار تراكمهم الفكري والسياسي العميق.
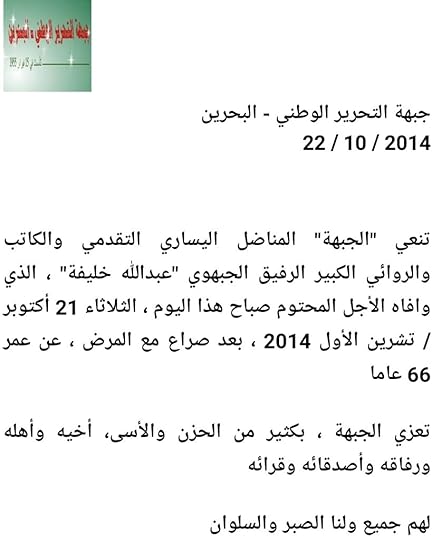
حين يبقى الموظف أو الوزير أو النائب مستقلاً في فكره، مواصلاً مشواره الكفاحي السابق، من موقعه، محاولاً تطبيق برنامجه السياسي عبر سلطة تنفيذية أو تشريعية أو بلدية، فإنه يكون وفياً لتاريخه، ومتواصلاً مع مشواره ومخلصاً لتلك السواعد الخفية التي رفعته من موقع الى موقع آخر، فتطور في حالته المادية الشخصية وفى حالته الفكرية والسياسية.
وفى الوضع الديمقراطي تستفيد الدول من الكفاءات في المعارضة؛ التي تجد نفسها تعمل من أجل تطور الدولة كذلك، لا أن تصبح العملية صراعاً لتدمير الطاقات الفكرية والسياسية العميقة لدى الشعب أو الأمة، فقط لأن مجموعة قليلة من الأشخاص غير قادرة على التطور أو التخلي عن ضيق أفقها الفكري والسياسي؟
#عبدالله_خليفة #المنبر_التقدمي #جبهة_التحرين_الوطني_البحرين
__ATA.cmd.push(function() { __ATA.initDynamicSlot({ id: 'atatags-26942-61a7f544283b0', location: 120, formFactor: '001', label: { text: 'الإعلانات', }, creative: { reportAd: { text: 'الإبلاغ عن هذا الإعلان', }, privacySettings: { text: 'الخصوصية', } } }); });November 30, 2021
عبـــــــدالله خلــــــــيفة  : الانتهازية .. لك وحدك أستمتع بها !
الكائنُ الذي فقدَ ذاته
أرقصْ على حبال الطبقات والتيارات وأرفعْ مصلحتكَ الخاصة لدرجة المقدس.
كنْ مع الحركة إذا رفعتك وقربتك من السلطة والمغانم وأهربْ عنها إذا حرقت شعرةً من جلدك.
كنْ ضدها إذا خسرتْ ولا تقطعْ الخيوطَ تماماً فربما أعطتك شيئاً في مستقبل الأيام.
كنْ مع الاشتراكية إذا كانت كراسٍ وتذاكرَ ودراسة مجانية وأبناءً يذهبون للنزهة.
لكنك دائماً مع الرأسمالية، هذه الملعونة اللذيذة.
كنْ مع اليسار إذا أغنى أهل اليسار، وكن مع اليمين إذا صعد نجمُ اليمين.
كن مع الالحاد إذا كان مفيداً وساعتهُ دانية وكنْ مع الإيمان إذا كانت قطوفه دانية.
كنْ ماركسياً تقدمياً حيث لا ضررَ ولا ضرار والجمهورُ الكادحُ يعطي تضحياته لها، وكنْ دينياً طائفياً حين ينقلب الجمهورُ ويصبحُ منشئاً لحصالات الخير والتبرعات ويسفكُ دمَهُ من أجل الخيال.
أنت أيها الراقصُ على حبال الطبقات والتيارات، يا لك من ذكي في زمن الغباء السياسي.
قامتك تصلُ للسماء وأنت تمشي وراء جيفارا وكاسترو وهوشي منه وتدقُ طبولَ الثورة في الغابات العربية الصحراوية، تحملُ بندقيةً من خشب وتقاتلُ في الفضاء، ولكن لا مانع من إستثمار أبناء هوشي منه في المصانع والسكوت عن الاستغلال الفظ للملايين منهم.
إذا جاء زمانُ الثورة العمالية والاشتراكية فأنت إشتراكي لا تقبلُ بربطةِ عنق برجوازية، وتدينُ الأكراميات وإنشاء المتاجر عند اليساريين المتخاذلين الانتهازيين، ولكنك لا تمانع من المتاجرة بالدولارات في الاشتراكية وبيع البضائع المهربة بالسر في روسيا السوفيتية.
جاء زمانُ الطائفيين ففجأة إكتشفتْ طائفتك، وبكيتْ على ماضيك الإلحادي، وكراهيتك للمساجد والمآتم حسب تصنيفك الطائفي، وعرفتْ مزايا مذهلةً في هؤلاء الطائفيين المقاتلين من أجل الديمقراطية وحقوق الجماهير، أو لكونهم عقلاء يؤسسون رأسمالية بنوك الخير ومساعدة الشعوب وينخرون الحكومات والأنظمةَ بدأبٍ من أجل مستقبلِ رأس المال الطفيلي، وفي الإمكان أن يقفزوا للسلطات فجأة. فأنتَ دائماً مع الخير وتقدم الشعوب والموجة الغالبة.
مع الدولةِ والرواتبِ المجزية والعلاوات والبقشيش ومع المعارضةِ الطائفية تضعُ في صندوقَها الأسود بطاقةً للمستقبل، وربما يحضرُ مقعدٌ عال في قادم الأيام، فالعاقلُ لا يفلتُ فرصةً.
مع الاشتراكية هناك ومع الشيعة هنا، ومع السنة هناك ومع الربيع ومع الخريف حسب الأسعار، ومع الألوهة ومع الإلحاد، ومع المقاومة ومع التراكمات النقدية حسب الطلبات الوطنية والعالمية والشركات المتعددة الأيديولوجية.
التناقضاتُ تملأكَ ولكنها لا تدمرك، كيف تُدمرُ حصالةٌ؟ وكيف يفلسُ بنكٌ إيديولوجي سياسي متحرك؟!
التناقضاتُ تصيبُ المناضلين الخائبين الذين لا يغيرون مبادئَهم حتى في الأعاصير، الذين إذا قلّ أنصارهم بقوا، وإذا كثروا لم يغتروا. يكتفون بضلع من بناية، ويزدهرون في البساطة والشظف والفرح.
أما أنت فعملاقُ عصرك ترتفعُ عن هؤلاء المحنطين، وتزدهرُ أسهمك ومدخراتك، وترهفُ السمع لأي تغير في الذبذبات السياسية والمالية، وتزحف وتزحف حتى تهترئ نفسك ولا يبقى عظيمٌ في روحك، تتحسُّ موجات الهواءِ الصغيرة لتتعرف الاتجاه القادم وتبقى في الاتجاه السائد.
قدمٌ في الرأسمالية وقدم في الاشتراكية، قدم في اليسار وقدم في اليمين، قدم مع الإرهابيين وقدم مع الشرطة العربية حسب مسار الأسهم.
هؤلاء أعداؤك الذين كانوا يريدون قتلك فكيف تظهر بينهم وتزرعْ زرعهم، وهذه أوراقكَ كيف توقفت وأهترات، وهذا مسرحك كيف هدمته، وهذه أدبياتك كيف توقفت وهذه صحفك كيف أهترأت، وهذه خطاباتك كيف مُحيت، وهذا تيارك كيف دمرته، وهذا شعبك كيف تلاعبتْ بمصيره؟
تسلقُ البرجوازية الصغيرةِ الديني
في زمنيةِ الرأسماليات الحكومية القومية (الاشتراكية) كان تسلق البرجوازيات الصغيرة على أساس الشعارات اليسارية التوحيدية، حيث كانت الأنظمة بحاجةٍ لتوحد شعبي واسع من أجل بناء البُنى التحتية.
لكن التسلق على ظهور العمال والفلاحين عبر رفع شعاراتهم لم يؤدِ لتغييرٍ كبير في حياة هؤلاء العاملين. والبرجوازيات الصغيرة العسكرية من ضباط وموظفين ومثقفين إغتنى بعضُها وفرشتْ الأرض الاقتصادية السياسية لرأسمالياتٍ نصف ليبرالية وفوضوية في أغلب نماذجها، ولم تخلُ من القبضة الحديدية، إرتفعتْ فيها جماعات حكومية إلى مصاف النبلاء وتهدمت فيها شعارات الجمهورية والاشتراكية.
وحين أفلستْ شعاراتُ القومية والاشتراكية الحكومية الشمولية ظهرتْ البرجوازياتُ الصغيرة بديكوراتٍ جديدة هي الديكوراتُ الدينية.
لم تستطع أنظمةُ الرأسمالية الحكومية إزالةَ الإقطاع، وأدت فوائضُ النفط الوفيرةِ التي جرتْ في البلدان الصحراوية إلى إنعاش الإقطاع الديني مجدداً حيث سال لعابُهُ من التحول الجديد.
وهو إنعاشٌ غذى الشركات المالية والنصوصية الدينية وعودة الأساطير الخرافية للطائفيين السياسيين.
فجأة ظهرت دعاوى الإيمان وحجَّ اليساريون المتطرفون الذين كانوا يزعمون أن الإسلامَ دين وثني، وتحول آخرون لفتح المكتبات الدينية يستوردون الكتب والأشرطة الصفراء يعيدون الجمهور بها الجمهور للعصور الوسطى.
وفيما كانت بعض المكتبات تزخر بالمؤلفات الإنسانية الأدبية والعلمية صارت على كل الواجهات الكتب الدينية المطبوعة في مطابع حكومية.
وفجأة إختفت الفروق بين التنظيمات الوطنية العلمانية والتنظيمات السياسية الطائفية.
وتبدل المروجون للسياحة والمشروابات الكحولية كذلك إلى مروجين للتدين وطاعة ولي الأمر والاقتداء بالسلف الصالح، مثلما يكتشف قادةُ بعض الفصائل أهمية اللحى لمنع إنتشار الجراثيم في الذقون.
الترويج للجماعات الطائفية السياسية من قبل هذه المجموعات التي إنهار وعيها النضالي الديمقراطي الحديث جاء في أعقابِ ظهور قطبي الصراع الحكوميين السني والشيعي في المنطقة حيث يزخُ كلُ قطب ماكينته الطائفية بالمواد المطبوعة والمروجين المتنقلين بين الجمهور بشكل مكشوف أو مقنع ثم صارت الفضائيات والوسائط الحديثة تغذي بشكلٍ هائل نقل التخلف والعداوات بين المسلمين.
عودةُ الإقطاعِ أو إستمراره في البلدان الصحراوية والقروية النفطية قبل البلدان العربية الحكومية العسكرية المتجهة للأزمة ثم الانهيار، هو بسبب عدم تحولاتها مثل البلدان الأخرى العسكرية التي أجرت ضربات أكبر للحياة التقليدية، فجاء تأخرُها الفكري السياسي بسببِ عدم وجود فئات وسطى وعمالية تحديثية واسعة، فكانت أشكالُ الوعي والثقافة غيرُ منتشرة بتوسع بين الجماهير، فيسهلُ خداعها من خلال بعض الشعارات وإستثمار تقاليدها وإرثها وجرها للنشاط السياسي العنفي الكامن أو الظاهر، كما أن جذورَ المنظمات الطائفية السياسية وأعتبار هذه البلدان مركز الهروب للجماعات الدينية، كل هذا جرّ جماهير هذه البلدان للحراك السياسي الجماهيري الفوضوي.
ولهذا فإن الجماعات البرجوازية الصغيرة المتذبذبة بطبيعتها وعدم رسوخ الرؤى التقدمية والديمقراطية داخلها تنجرُّ للسائد دائماً، ولكن قفزة هائلة من الاشتراكية والقومية والحداثة إلى الطائفية وثقافة الإقطاع كانت مفضوحة.
ضخ الأنظمة لجزء من ثروات البلدان لهذه الجماعات وتوسيعها وهي الواسعة أصلاً كجزء من بُنى الحرف ومعامل ومصانع المواد الأولية التي تغدق الفوائض على القوى المتنفذة نظراً لعدم وجود أسلوبِ إنتاج وطني متجذر يغذي مختلف الطبقات، يؤدي لتحولات الفوضى والانقلابات الخطرة على التطور.
وهكذا تنقلبُ تنظيمات كانت تتعيش على التسول من الأنظمة إلى أن تكون عدوة لها وتجد سببيات واهية للفوضى السياسية، وتتحالف مع تنظيمات يسارية كانت تعتبرها لوقت سابق قصير ملحدةً خطرةً على الإسلام!
اللاعقلانيةُ والذاتيةُ والمصالح العابرة وإنتهاز الفرص والتلاعب بالمذاهبِِ والأديان والقيمِ والركوب على ظهور الجماهير غير الواعية وعدم خلق التراكمات التحديثية بصبر وحكمة وبإقناع للشعب وكل هذا لكي تصبحُ هي في مركز الزعامة والسيطرة ويتفق معها أناسٌ لهم مثل هذا الطموح الذاتي وعدم التجذر في المصالح والمبادئ العامة.
إستخدم العلمانيون المرتدون نفس طرق الكهنوت في إستغلال الدين وإفراغه من مضمونه النضالي وتأجيره للقوى الاستغلالية للهيمنة على الناس بدلاً من الانتاج العقلاني التحديثي وتطوير الوعي.
الانتهازيون والفوضويون
مع غياب التيارات العقلانية الوطنية الديمقراطية انفتح الباب للفوضويين والانتهازيين للسيطرة على الساحة العقلية المعطلة للجمهور.
انتشار الوعي الديمقراطي توارى بسبب هذا الكم من الفوضويين والمسعورين سياسياً والحمقى فكرياً، فهؤلاء كانت مهمتهم الحقيقية خلال سنوات عديدة سابقة هي تخريب ساحة النضال، ففي أيام العمل السري كان تجنيد الأعضاء ودفعهم في معارك غير متكافئة، وجر الشباب لأعمال تفوق فهمهم، وكان شعارهم(اعترفْ وأخرجْ من السجن) مما صحر القواعد وغيّب المناضلين والتراكم الديمقراطي والتماسك النضالي والصلابة السياسية والأفق الفكري المنفتح.
أعتمد هؤلاء على لغة الصراخ والانفعال الشديد مما جعل سياسة الحماقة هذه تولد(قادة) فوضويين عنفيين كل قدراتهم تكمن في الصراخ وعدم فهم الواقع والمستقبل، مما أدى إلى انتشار مدرسة الحماقة هذه خاصة في الجيل التالي الذي أجدب يسارياً ووطنياً ووسع من الدينيين الطائفيين الذين أوصلوا هذه الحالة للذروة، وقسموا المجتمع، وهدموا الفكر والتطور.
ما زال هؤلاء المغامرون الفوضويون يحكمون الصفوف الأولى في الجماعات السياسية، ويكرسون نهج الحماقة حتى بعد أن أُصيب الجيل الأول بالخيبات والاختفاء والهزائم.
هذا صّحر الواقع السياسي من الوعي، ومن رؤية المستقبل والانضباط العقلاني السياسي، وجعل الجملة الحادة الصاخبة، واستعمال الأيدي والألفاظ البذيئة والادعاءات السياسية المراهقة حتى في البرلمان بديلاً عن العقلانية والتراكم السياسي الطويل وتكوين الجماعات المعتدلة المتنفذة ذات المشاريع السياسية وفهم مشكلات الجمهور والبلد والمساهمة في حلها.
هذا مكن الانتهازيين من جهة أخرى من فرش نفوذهم في الواقع السياسي المريض، فهؤلاء لا يملكون أي وعي وأي رغبة في إصلاح المجتمع بقدر ما يسعون لتكوين مصالحهم الخاصة وتكوين شلل الفساد العامة الخاصة.
وقد حصلوا على فرصهم مع غياب العقلانيين والوطنيين المخلصين بعيدي النظر وأصحاب البرامج والثقافة السياسية العميقة فعطلوا البرلمان والصحافة والوعي عامة.
وهكذا بدلاً من دحر الفوضويين واستخدام ما في خطاباتهم من نواة عقلانية وفرزها عن الفوضى والصخب والعنف الذاتي، يقومون برفض كلَ شيء وعدم طرح البديل وعدم التعبير عن مشكلات الناس والمجتمع، مصورين أنفسهم بأنهم دعاة العقل وليس قوى الفساد السفلى المشاركة القارضة للمال العام.
تقوم الفوضوية والانتهازية بدور متكامل مشترك وهو منع الوعي السياسي الناضج من التكون ومن تشكل قوى الإصلاح الشعبية، وتحولها لتيارات مؤثرة.
وبهذا يفقد الجمهور أمل التغيير، وينتشر فيه اليأس ويفرز ذلك قوى التطرف والعنف والجريمة.
بدون النقد وتكوين البديل الإعلامي وطرح النماذج السياسية المركبة الجامعة للنقد والمسئولية التعبيرية والحكمة العملية، فإن هذه النماذج المخربة للعمل السياسي الوطني سوف تنتشر وتمنع التطور مستفيدة من الفوضوية والمراهقة السياسية.
انتهازيةُ التحديثيين
تعددت علاقات فئات البرجوازية الصغيرة بالإقطاع وهي تعتمد على طبيعة العصر ونمط الإنتاج. حين نقرأ كيف يتدهور وعي هؤلاء ويتراجعون من الحداثة إلى المحافظة والطائفية فلا بد من قراءة ثقافة المرحلة، وزمنية الإقطاع السياسي فحين تكون الدولةُ العربية أقوى من نفوذ رجال الدين ممثلي الإقطاع الديني، هنا تكون لديها من الموارد ما يكفي لشراء ذمم هؤلاء وحين تفقدها يلجأون لغيرها.
إن توجه مجموعات و-لا نقول تيارات فكرية سياسية- إلى النفخ في الجماعات الدينية الطائفية بشكل كبير ثم التراخي عن ذلك بسبب قلة الدفع المالي لها من الجماعات الدينية التي صارت هي الممول الكبير يوضح طبيعة التدخلات السياسية الفوقية والأجنبية وحرف هذه الجماعات عن التجذر في أرضها والتغلغل في تحليله ودرسه وكتابة بحوث وبرامج مؤصلة لقضاياه.
إن هذا الوعي المسطح التجهيلي يقود الناس للكوارث، سواء في اختياراتهم التشريعية أم في نضالاتهم اليومية المجمدة عموماً، ولهذا فإن مبدأية التحديثيين وتوجههم لنشر الخيارات الفكرية الوطنية والديمقراطية والتقدمية غدت طوق النجاة.
أثبتت المرحلة خطورة الانتهازية والكوارث التي سببتها والحصاد المالي الشخصي لبعض قياداتها التي لعبت على الحبال واختارت الدوائر الرسمية وعطائها فكانت مع الطائفيين ساعة صعودهم ومع المال والنفوذ ساعة قوته.
ونجد في انتقالاتها الجغرافية والحياتية والعملية غياباً لأي وعي متجذر وما هي سوى شعارات زائفة كتحبيذ الاشتراكية والدعوة إليها وأصحاب الدعوة همهم جمع المال!
وما تزال قواعد هذه الجماعات غير قادرة على النقد وطرد الانتهازيين من صفوفها وما تزال تعطي لهذه الوجوه المتراقصة على الحبال السياسية مكاناً مهماً.
وهكذا نرى الأشكالَ الاجتماعية من البرجوازية الصغيرة كيف تتذبذب حسب تدفق البحر الاجتماعي، فحين تكون الدولة العربية قوية وذات موارد وتجزل لهم العطاء يؤيدون الكل التحديثي من التطور، ويعادون الموجات الدينية، حتى إذا بدأت الموازين تختل وضعفت مواردُ الدولة العربية وتفاقمت أزماتُها انتشر الجرادُ الطائفي يأكلُ الحقولَ ويشيعُ القحطَ في الحياة وراحت هذه الفئاتُ نفسها تصعد يافطات مختلفة، تؤيد العودة للوراء وهدم التطور الوطني والحداثة والعلمانية.
وإذا كان الجماعات الدينية القديمة قد فككت الجماهيرَ العربية وقسمتها إلى فسيفساء وأهلتها للسيطرات الأجنبية فهذا ما يقوم به الطائفيون المعاصرون وتوابعهم من البرجوازيين الصغار الانتهازيين المتذبذبين، الذين وجدناهم في مرحلة يرفعون شعارات الثورات العمالية الحمراء والبندقية وسحق الأديان ولا يحللون أزمات الدول وعدم ضبطها للتطور والقيام بإصلاحات جذرية لصالح الجماهير العربية منساقين مع التدهور العام في وعي هذه الجماهير مكرسين التخلف فيها.
في الزمن الراهن كذلك يتصاعد الشكلُ اللاعقلاني من الوعي والتطور، فلا تعرف الجماهير كيف تغير، وتتدفق جماهيرٌ متخلفة في الدرس والعمل على المدن وتطرح مستويات فهمها المتخلفة.
وتقود هذه المعارضات وطرح البرامج المحافظة إلى انقسام الناس وتأييد الفوضى وعدم التوحد، وتتوجه فئات البرجوازية الصغيرة لتأييد الصاعد الذي يزداد طائفية وتخلفاً وتفكيكاً للصفوف والعودة للوراء.
هكذا تنقسم النقابات والمعارضة والأشكال التوحيدية في العمل السياسي وتتوجه فئاتُ البرجوازية الصغيرة لتأييد اللاعقل في المعارضة أو الموالاة، ويغدو الإقطاع الديني هو الأقوى ولهذا نرى الاقسام بين الدول الإسلامية بمنحيين، طائفيين رئيسيين خطرين متصادمين.
ويغدو الخروج من العصر الحديث وتمزيق البلدان ونشر الفوضى والتخلف والحروب هو البرنامج الحقيقي لهؤلاء الذين يركبون الموجات ولا يقدمون حفراً عميقاً في الحياة ولا يضحون بل يريدون الناس هم الذين يضحون من أجلهم. ومن هنا نجدهم يقيمون علاقات مشبوهة مع كل الجهات حسب الفوائد التي يجنونها.
انتهازيةٌ نموذجيةٌ
منذ أن أخطأ بعضٌ من أفراد الجيل الوطني القديم في التحالف مع الطائفيين، نظراً لهشاشة جذورهم الفكرية السياسية العلمانية الوطنية، والأعشاب الضارة تتالى من هذا المنبت.
قام الجيل بتضحياته ومغامراته وكان من الضروري نقده، لكن الحالة النموذجية الانتهازية رغم تكرارها لأهمية العقلانية والهدوء التحليلي وبعد النظر تروح تصرخ هائجة وتحيل الموقف وتشريح الجيل القديم لحالةِ تشنجٍ شخصية بدلاً من تطبيق تلك المفردات الكبيرة في الموضوعية والعلمية لكون القائل الناقد لا يعجبها ولا يقترب من مستنقعها وانتهازيها.
ويمكن أن يستفيد بعض المتعلمين من خلفياتهم السابقة، ويتلاعبوا أكثر بقضايا النضال بدلاً من تجاوز الجيل القديم الذي لم تتح له فرص الدراسة الأكاديمية.
خلطهم بين العمل السياسي والدين يغدو تلاعباً، فهم من المتعبدين ومن الانتهازيين. فأي جهة تجلب مصلحة ذاتية يمكن تسويقها. من حقك أن تصلي لكن ليس من حقك أن تلغي تاريخ التيار الوطني في العلمانية وفصل الدين عن السياسة!
حين يغدو الصراع السياسي الطائفي حالة اشتباك عامة يجري تصويرة كثورة وجر الوطنيين إليه، وحين يفشل يتبدل القناع، وتـُفضل المصلحة الخاصة. ولا تـُنقد هذه الأخطاء وتـُحلل بل تـُترك للاستفادة من غموضها!
حتى كوارث الشعب العارمة لا تنجو من الفلتر المصلحي الذي يقضم بعض خيراتها رغم الضحايا والكوارث!
كتاباتٌ هزيلة تستفيد من أي موقع، ويهمها التراكم المالي لا النقدي، لا تقوم بتجذير أي تحليل، وتحاول التقليل من شأن الكتابات الوطنية التقدمية وتخريب حتى أسماء أصحابها والتصغير من نتاجاتهم والتعتيم على وجودهم بأشكال صبيانية.
هذا الحقد نتاج تضخم ذاتي وإعطاء هذه الذات الهزيلة فكرياً مقاماً رفيعاً، فهي يجب أن تكون القائد الأول والزعيم المعترف به رغم الهزال الفكري والتلاعب السياسي وغياب النتاج الموضوعي الدارس للبنى الاجتماعية والصراعات الطبقية.
تخريب التيار هو جزء من المصلحة الذاتية فكلما كثر العميان المتخبطون في الليل السياسي كلما وجدت هذه الذات فرصاً للتلاعب بمصير الوطن والناس.
هي جزء من هذا الخراب الذي أمتد عقوداً وهو خريف اليسار حيث لا جدل عميق ولا شخصيات تؤصل الماضي وتصعد بإنجازاته، فهي مشغولة بمنافعها واستغلالها للماضي والحاضر، أو هي جامدة لا تقرأ وتدرس.
وعي ديمقراطي غائب
في خلال مشكلات الرأسمالية الحكومية في العقدين الأخيرين من القرن العشرين تفجرت أزمة، لكن أشكال الوعي السائدة للفئات الصغيرة وهي المنتجة لأشكال الكتابة والفكر والأدب والفن لم تستوعبها.
تحول الرأسمالية الحكومية إلى رأسمالية ديمقراطية متعاونة مع الرأسمالية الخاصة والطبقات العاملة الشعبية لتشكيل بُنية اقتصادية وطنية متضافرة، احتاج ويحتاج إلى وقت موضوعي.
لم يكن بإمكان شعبنا أن يعود إلى كونه شعباً موحَّداً، بعد عمليات التحولات الاقتصادية السريعة التي تمت على ذلك الأساس الاقتصادي السياسي.
برزت أشكالُ الوعي الطائفي السياسي عائدة لما قبل تاريخ الهيئة، وتداخلت مع أشكال الوعي الطائفي في المنطقة، حيث تخمرت خلال سنوات عديدة سابقة.
القوى السياسية الشيعية التي لبدت في حقول الذرة الريفية خاصةً على مدى عقود طرحتْ نفسَها كخيار قيادي رافضة أي تداخل وطني، خائفةً من ذوبان جماعتها في أي حراك ديمقراطي.
الجماعات البرجوازية الصغيرة نتاج انهيارات الرأسماليات الشرقية الروسية والعراقية والمصرية والليبية وغيرها اندفعتْ لتأييدِ هذه القيادة. وكانت احداثُ التسعينيات معلماً لم يعلم هذه الجماعات، بعد أن اختنقتْ قدراتُها الفكريةُ السياسيةُ في فهم تطور العالم الشرقي كتشكيلة رأسمالية حكومية في طور التحول من الاستبداد إلى الديمقراطية.
لقد جابهتْ قوى البرجوازيةِ الصغيرةِ الضيقة الفكرِ، الرؤى الديمقراطيةَ بعصبيةٍ من دون درس، وواصلتْ ذلك خلال عقد التحول الديمقراطي البحريني الصعب بداية 2000، وكانت تترجرجُ بين ولاء للقيادة الطائفية الشيعية وبين محاولات لتجاوزها وطرح بديل، لكن ذلك لم يحدث للمستوى الفكري المحدود، وقدومها من ولاءات صغيرة مفتتة، وغياب إنتاجها الفكري السياسي النقدي.
كان الحفرُ المعرفي في الواقع، ودرس الاقتصاد ومشكلات الجمهور والانتقال من عقلية ردود الفعل والعفوية صعبا عليها، فبقيتْ في مستواها السابق.
لهذا لم تجدْ في التجربةِ الإيرانية استمراراً لرأسمالية الدولة الشمولية الشرقية وقد صارتْ عسكريةً خطرة، مثلها مثل النموذج السوري، الذي بقي لدى هذه الجماعات محتفىً به، وتذهبُ إليه الوفودُ وتُعقدُ المؤتمرات لما يُسمى (اليسار) فيه.
وبذلك وجدتْ هذه الجماعات تسمياتٍ أخرى للقيادات الدينية السياسية الشيعية تبعدُهَا عن التوصيف الموضوعي، وتجعلها ضمنَ المنظور (الشعبي الديمقراطي)، وليس باعتبارها قوى طائفية محافظة، تستعبدُ الجمهورَ وتمنعُ تطورَه الديمقراطي.
مستوى الداخل والخارج يلتقيان، مستوى النظام الإيراني وتطوراته نحو الشمولية العسكرية والتغلغل في المنطقة وتمركز قبضته، لا ينفصلُ عن تصاعدِ الولاء له، وإثبات نموذجيته وقيادته لدى هؤلاء.
الجماعاتُ التي انساقتْ وراء ذلك لم يتشكل المخاضُ الديمقراطي داخلها، فلم تُعدْ النظرَ في تجربة الاتحاد السوفيتي الشمولية، ولم تعد النظرَ في تجربة العراق وبقية التجارب الدموية. أي لم تقدر بأدواتِ فهمها المحدودة أن تفهم مسار الديمقراطية في الشرق والعالم. لهذا ارتبكتْ ممارساتُها، وقادتْ جماعاتِها لأخطاءٍ جسيمة.
ولهذا فإن الصراخ الحاد المضاد والتوجه للطائفية المحافظة السنية هو شكلٌ آخر لذات الخطأ. والبقاء ضمن العقلانية والديمقراطية والعلمانية والوطنية مع درس تجارب المنطقة وأنظمتها بموضوعية، هو البديل عن التشنجات والشعارات المدوية الصارخة.
هناك البرجوازية الصغيرة تلقي بذاتها في أحضان ولاية الفقيه، عجزاً عن التغيير الديمقراطي في طائفتها، وعجزاً عن الإنتاج الفكري التجديدي، وهنا يحدث ذات الموقف، حيث يتوجه النقد إلى السطوح، ويتشكل موقف محافظ آخر ويجري عدم نقد الرأسمالية المحلية وعدم تطورها الديمقراطي في الاقتصاد خاصة، وعدم معالجة مشكلات الجمهور العامل والرأسمالي الوطني بفهم عميق.
إن النظام الإيراني كرأسمالية شمولية عسكرية ذات نفقات هائلة وهو في حالة اختناق وتتصاعد أزمته، ولهذا فإن الصبر هنا ضروري مع نقد هذه الاتجاهات، حيث سقوط هذا النظام هو الذي يمثل النقد الحقيقي لها. النظرة الشاملة ورؤية هذه الأنظمة ونحن جزء منها كسيرورة تاريخية معقدة، إنها تتخلص من المركزية والقطاع العام المهيمن، وتتوجه لتعاون مختلف القوى الاقتصادية، وتبعد الأفكار الدينية السياسية، وتتقارب في تجاربها وتتحول الشعوب إلى قوى القرار.
أسباب تدهور وعينا
لا يتعلق تدهور الوعي الذي يتجسد في الآداب والفنون وفي الثقافة وفي الوعي السياسي بانتشار الأنانية والانتهازية فقط، بل كمعادل لهذا الانتشار تضاؤل الوعي المادي الجدلي، وهو وعي الحفر في الحقيقة، في كشف تناقضات الأفراد والفئات والمجتمعات.
حين تلاحظ اللحظات التاريخية بازدهار المجتمعات، بدءً من الثورة الفرنسية والثورة الروسية والصينية وثورات التحرر الوطني تجد إن مثقفيها البارزين الذين وضعوا بصماتهم على التطور السياسي العاصف، الذي غير مجرى بلدانهم والعالم، فعلوا هذا حين اقتربوا من الوعي المادي الجدلي، حين وجهوا ابصارهم لتناقضات الواقع والثقافة السائدة، متخلين عن أوهامهم الفردية والطبقية، مزيحين هذه الغلالة من الأفكار الُمسبَّقة، ومن الأوهام.
وقد انتهت تلك الموجة من الوعي التقدمي الذي ساد القرن التاسع عشر والعشرين في أوربا وآسيا، وهدم الإمبراطوريات الاستعمارية، بسبب من شعارية هذا الفكر وتبسيطه في العديد من المحاور، فقد وقف عند هدم المجتمعات التقليدية وكان أمراً بسيطاً قياساً لبناء المستقبل الذي أُخذ بأفكار نقصها ذلك الفكر الجدلي، لقد تصورت إنها تبني مجتمعات تنتهي فيها التناقضات، والتناقضات لا تنتهي، وتصورت دولةً تزيل الطبقات، والدولة ذاتها جهاز قمع، وتصورت أنها تنهي الرأسمالية في الوقت الذي تقوم بتشكيلها عبر نفس جهاز الدولة. فهي لم تكن تفهم التناقضات التي تشكلها.
وانظر كيف كان حال وعينا في الخمسينيات والستينيات مزدهراً بحركات التغيير في السياسة والثقافة، ثم كيف تدهور مع الموجات الدينية، فصارت ثقافتـُنا العامة ضحلةً.
إن الموجات الدينية الجماهيرية هذه تعتمد على وعي طفولي ساذج، فهي لا تفهم تعقيدات المجتمعات المعاصرة، وتناقضاتها الطبقية والثقافية، وهي تضعُ فوقها أفكاراً خيالية غيبية، وهذا نتاج قيادات مثقفيها المحافظين الذين يخافون الحركة النضالية الشعبية، فيقسمون الشعوب إلى طوائف ويقسمون العائلات إلى رجال ونساء، ويقسمون الثقافة إلى غيب وواقع.
وهم يعيدون ثقافة ضعيفة الاتصال بالعلوم الطبيعية والاجتماعية، ثقافة كانت تعتمد على معلوماتٍ تقدمُها الِحرفُ والأشغالُ اليدوية، في حين انتقل العالمُ منذ قرون لثقافة تعتمد على التصنيع.
إدخالهم الدين في السياسة ليس نتاج التقوى بل الأنانية، فهم عاجزون عن التطور العلمي، وعن الشجاعة في تحليل المجتمعات وتناقضاتها الحقيقية، فالتناقض بين العمل ورأس المال، التناقض بين الطبقة الغنية والطبقات الفقيرة، التناقضات بين الشعوب والاستعمار، التناقضات بين الثقافة العلمية والثقافة الخرافية، التناقضات بين ثقافة الغرب المتقدمة وثقافة الشرق الهزيلة، كل هذه التناقضات المحورية في العالم لا يقيمون بتحليلها، مثل النشطاء في مجال الثقافة والإنتاج الفكري.
إن الإنسان المتفاعل مع الأحداث يذهب لخطبة رجل الدين ليسمع كلاماً عاطفياً وفيه إثارة غيبية غير محددة، فرجل الدين لا يحلل استغلال الشركات والبنوك، ولا العلاقات الاقتصادية الدولية التي تأخذ بخناق هذا المواطن المتألم، لأنه ربما صاحب علاقات بهذه القوى المادية، فيركز على العلاقات الروحية الغامضة. خطابُ رجل الدين هنا خطابٌ أناني. وخطابُ رجل الدين هذا سلسلة من خطابات مثقفي التقوى هؤلاء الذين لا يريدون إثارة الشركات والوزارات ويكشفون الأسعار والأجور والتلوث والاستغلال، محلقين في عالم من التخيل الخاص والتجارة بالرموز المقدسة لأصحابها.
ويقول الفنانُ لماذا أرسمُ آلامَ الإنسان وهل يمكن أن تـُعرض في معرض؟ بطبيعة الحال سيقف القائمون على المعرض دونها. ومن سيشتريها؟ ويمكنني أن أرسم ألواناً وأشياء تجريدية أو صوراً فوتغرافية جميلة للصحراء والجمال والنخيل وهي تـُشترى.
ويقول الكاتب لا استطيع أن أقوم بتحليلات وتحقيقات ومسرحيات وأفلام تكشفُ جشعَ الأغنياء والحكومات وأعري العائلات المحترمة لا كتفي بمسرحيات ضاحكة تخفف عن الناس أحزانهم، ومسلسلات تتكلم عن قضايا صغيرة عائلية وخاصة مسألة الطلاق، فكم يؤدي الطلاق إلى كوارث!
يعيش المنتجون للأفكار والثقافة السائدة في عالم من الكذب الواسع، وهم نتيجةً لجلهلهم بالدين ولعمومية مقولاته، يستعينون به لكي يستروا تنازلاتهم لقوى الاستغلال، فإذا سرق المثقف قال سأذهب للحج لا لشيء سوى أن يخفي ما قام به، وهذا تدهورٌ غاصَ فيه الآن المثقفُ عوضاً أن يكشف السرقات العامة، ويذهب للحج، فتغدو المظاهر العبادية جزءً من عالم الاستغلال، ويتوسع الأمر في ظل تحويل ذلك إلى عملية تلاعب سياسية واسعة بالدين، وكون التزام المرشح بالعبادات هو ضمان لصحة انتخابه ولصحة العمليات السياسة الوطنية!
ويعمق الجمهورُ الجاهلُ هذه الحالة، فبدلاً من أن يطلب من السياسي المرشح شهادةً عن نضاله ضد الاستغلال ولرفع حياة الجمهور المعيشية، يطالبه بكشف حساب لعدد صلواته! فالجمهور يزيد أوضاعه سوءً، فإضافة للاستغلال الحكومي على كاهله يظهرُ استغلالُ النواب.
إذن الوعي المادي الجدلي، الوعي بالتناقضات الطبقية والاقتصادية عامةً وتحليلها وكشفها، ومعرفة الوسائل السياسية المرافقة لهذا الوعي والمتوجهة لتنظيم الجمهور لكي يناضل لحلها، هو العاملُ الفكري المرافقُ لنمو الشعوب نحو الحرية والتقدم، فهو وعيٌّ يحددُ المشكلات الرئيسية ويوجه الإرادةَ البشرية نحو حلها. فتنظيمُ الشعب الصيني الذي يبلغ أكثر من مليار يعتمد على نخبة صغيرة وجهته نحو حل مشكلاته الحقيقية في الواقع، وليس في الخيال الديني أو الرومانسي أو الذاتي الأناني. إن مشكلاته هي في ضعف المصانع والتجارة والعلوم الخ.. وتأتي الحلولُ محددةً، وبعد ذلك من يؤمن بماو فليؤمن ومن يؤمن ببوذا فليؤمن، فساحة الواقع لها مكانتها ومناهجها وساحة الغيب لها مناهجها.
خلقت الشعوبُ بهذه المادية الجدلية ثورات نهضوية كبرى انتقلت بها من خنادق المتخلفين إلى فضاء المتقدمين.
الانتهازية وغياب الإنتاج
لا يقوم الموظف المستند على كرسي فوقه بتحقيق إنتاج حقيقي.
والسياسي والمثقف والصحفي الذي يرتكز على قوة سياسية تسنده مردداً شعاراتها العامة، دون قدرة على الخروج أو النقد، لا يستطيع أن ينتج سياسة أو ثقافة أو صحافة!
هكذا فإن التيارات السياسية التي ارتكزت على سند مادي لم تنتج شيئاً في النظر السياسي أو في الفكر العام أو في الثقافة، فتجد أن التيار الذي تسلق أنابيب الخير الحكومية لم يكن قادراً على نقد واقع أو التعبير عن رفض، ولهذا عجز عن إنتاج تفكير مستقل، فنجد أنه لا توجد حيثيات تؤيد إبداعه في مجال من المجالات، إلا حين كان أفراده بسطاء، يقفون في الشوارع ويشاركون في الصراخ السياسي، لكن حين راحوا يتسلقون وينظرون للمعاشات أكثر من نظرهم للآلام الشعبية، تخثرت اللغة في حناجرهم وذبلت الأفكارُ في عقولهم!
وحين تحولت التيارات إلى ثنائية الداخل والخارج، ثنائية النضال السري والنضال الخارجي العلني، التضحيات الجسيمة في الداخل ومهرجانات الدعاية في الخارج، تكونت فئتان؛ فئة داخلية مضحية، وفئة خارجية مستثمرة، ويمكن القول بتعميم حذر بأن بعض الانتهازيات تشكلت في الخارج أكثر من الداخل، وأن الطرق الانتهازية في الخارج ربما قادت إلى يباس الوعي وعدم الإنتاج فحدث لها استرخاء كفاحي وعجزت عن تطوير المفاهيم الوطنية العلمانية، فصدّرت هذا الاسترخاء للداخل المُنهك العاجز عن إيجاد قوى قيادية علمانية ديمقراطية مستقلة.
لكن مناخ الاسترخاء والانتهازية لم ينته لأن ثمة فرصاً جديدة تكونت مع عملية التحولات السياسية، وكان (التشعبط) على أكتاف الحركة المذهبية السياسية هو المحاولة ربما شبه الأخيرة، خاصة بعد أن تجمعت الحركات المذهبية السياسية تحت قبة واحدة، وصارت هي المرجعية السياسية الرسمية المعارضة من داخل النظام.
لا تختلف الحركات المذهبية السياسية في تكوينها عن الحركات الوطنية العلمانية جوهرياً، فهي كذلك ترتكز على غياب الإنتاج الفكري، وإنما على سواعد الجمهور البسيط المضحي، والذي تبين لبعض النفر فيه، كيف أن المصالح المادية تلعب دوراً كبيراً في تكوين التيارات السياسية، وأن قادة التيارات المذهبية (تشعبطوا) هم كذلك على سواعده، لكي يرفعهم إلى فوق، وفي البدء كان سقف هذا الفوق كبيراً حتى يصل إلى تغيير شاسع، ثم تواضع بحكم عدم قدرة الخطاب المذهبي السياسي أن يغيرَ شعباً متعدد المذاهب، لكن هذا الخطاب كذلك غير منتج فكرياً، فهو مثل قرناؤه السابقون مجرد مرددٍ للشعارات.
وكل هذه الفئات الاجتماعية السياسية المتداخلة مرت بزمن سابق مختلف، فيه العسف وصعوبات المعيشة لتيارات تكافح، ولكن الآن تغيرت الظروف وصار بإمكانها الجمع بين المعيشة الجيدة والإنتاج الفكري، بين المعارضة وتحقيق مطالب الجمهور، ولهذا إذا استمرت في نفس الماضي الإنشادي، وتحويل المنظمات إلى مآتم للبكاء على الراحلين، واستمرت في البطالة الإنتاجية، وعدم القدرة على الحفر في عالم الأبحاث والدراسات وتحليل ظروف الإنتاج والاقتصاد والسياسة والبيئة الخ، فتكون قد غلبت حياة الدعة ونقلت تقاليد الانتهازية الماضوية، ولم تستفيد من التحولات الراهنة، وهذا يقودها إلى ممارسات سياسية سطحية عاطفية، تظل الغوغائية هي المسيطرة عليها، بدلاً من تراكم ثمار التجربة والعلوم.
وإذا كات البطالة السياسية من نصيب القوى العلمانية الوطنية، فهذا مفيد كثيراً، فهو زمن مهم للدرس وإعادة النظر في التاريخ والتجارب، وليس لتكوين حلقات الأنشاد البطولي مع البخور، ولتبيان أوجه النقص خصوصاً، وتكوين التحالفات المبدأية القائمة على ترسيخ الرؤى، وتشكيل التعاون كذلك مع القوى المذهبية السياسية بما يقوي من تطور الوطن.
من العنف الثوري إلى الانتهازية
حين نرى المسار المؤلم للجماعات التحديثية التي بدأت حادة مخيفة في أطروحاتها ثم انتهت وهي تبحث عن المال بأي صورة، لا بد أن نقوم بدرس ذلك، فهو مسار معقد وقد يتكرر لدى المجموعات الدينية كذلك وربما بطريقة أكثر حدة وتعقيداً.
لنلاحظ ان الاهتمام بالأشكال والجوانب التحديثية المفصولة عن مضمون تغيير أحوال الناس، أي الاهتمام بالأنا على حساب النحن، وكذلك لغة الهجوم الحادة على الإرث والتقاليد وتوجيه المجابهة بين قوى المعارضة، تماثل الطرح قبل عقود أن حل كل المشكلات يمكن عبر البندقية ولغة النار.
ولكن مجموعات الفئات الوسطى المعبرة عن تجربة أقصى اليسار، كانت وهي تدفع ثمناً باهظاً من حياتها لمثل هذه الأفكار، لم تتعلم منها أثناء التجربة، وإذا غدا الحرمان مكروهاً، وتطوير وعي الذات الحزبية بالواقع وبالفكر غير ممكن لأسباب كثيرة، لهذا كان الاتجاه نحو النقيض، نحو المال والمراكز والشهرة والصداقة مع الأنظمة والحركات الشمولية ومع المهيمنين بشتى ألوانهم، والمهم خدمة الأنا.
كان هذا الإفلاس الفكري يتجلى بالوقوف عند المرتكزات الشمولية للنظام الشمولي القديم، (الاتحاد السوفيتي، والصين وكوبا) أو بالارتهان كلياً للتجربة الغربية، وتأتي عدم القدرة على فهم النظام العربي التقليدي الراهن، وتشجيع الأنظمة كذلك لانفتاحية الفئات الوسطى، في التوجه للانتهازية اليمينية هذه المرة، أو التشدق بألفاظ اليسار عبر جمل باترة وامضة؛ مع غياب الموقف التوحيدي لليسار والقوى الديمقراطية عامة..
إن هذا ينطبق على انهيار أنماط الوعي المستخدمة، كغياب الدراسة العلمية، وتخثر الشعر، وجمود القصة، وشكلانية اللوحة التشكيلية وموتها، وسفر الأغنية الثورية إلى الصمت والتجارة، وانتهازية القانون حسب مواقف الجماعة الخ..
إن العجز العميق عن التطور يولد أمراض جنون العظمة، وتشجيع الشلل لتخريب الثقافة الوطنية ومعاييرها الموضوعية، وتكريس النجومية وحب المال، وتفكيك الجماعات اليسارية والوطنية عموماً.
إن الخراب كان كبيراً في العمق، وهو خرابٌ غير مدروس، وغير معروفة آثاره، ولكن ظاهرة العجز عن الفعل، وتكرارية اللغة الميتة، والعودة للمأتمية، والاصطافات اللامبدئية، والعجز عن النقد العميق، هي وغيرها تشير إلى تخثر فعل ممثلي هذه الفئات الوسطى، وعجزهم عن العمل الاجتماعي الفاعل.
ومن هنا نجد أن الثقافة الرسمية السائدة في بعض الدوائر تشجع على كل ما هو منقطع عن الموقف المبدئي، والاحتفاء بالخارج، ولهذا فهم يشجعون ثقافة من موزمبيق لكن لا يمدون ايديهم للمنتج المنهار المحلي، إلا إذا تخلى عن ثقافته الوطنية المنتجة وتحول إلى أراجوز سياسي أو شعري أو تشكيلي أو مسرحي، فالمهم هو الاستعراضات.
لغد قامت القوى (التحديثية) بتقزيم بعضها بعضا، فتلك الجماعة تحتكر أغلب جوانب الثقافة المفيدة المدرة للأرباح، ولكن إلى ماذا قاد ذلك؟ إلى التخلي عن نقد الواقع، وعدم قدرة النتاجات ان تعري الأخطاء، وهذا الجانب لم يتغير حتى بعد أن أخذت الدوائر الرسمية تنقد نفسها. وتغدو التحالفات غير مبدئية، فالسياسي الذي ينقد بقوة وحِدة الواقع السياسي، يصمت عن نقد الواقع الثقافي الفاسد، فلم يمتلك منهجين مختلفين؟
ثقافة الانتهازية
يتوحد الانتهازيون في ثقافة ذات أنماط عامة، وهي الثقافة الأكثر انتشاراً في العالم العربي والأخطر حضوراً، ولا بد من درس قوانينها وتجلياتها كماة خام للدرس.
تنقسم هذه الثقافة إلى شكلين أساسيين، الشكل اليميني والشكل اليساري، لأن هذين النمطين يصوران نفسيهما بالدفاع الأقصى عن الناس، لكن هذا الدفاع الأقصى هو شكل من خداع الناس كذلك!
إن هذه الحمية والعاطفية الشديدة والكلمات الحادة ولغة الأستعراض والأدعاء هي أمور توحد الفريقين رغم تعارضهما الظاهري، فهما يعتمدان على خلق مزايدة ما سواء بهذا الاتجاه أو ذاك ويبتعدان قدر الإمكان عن التفكير الموضوعي.
فهناك دائماً فيهما انتفاخ ذاتي، يغطيانه بألفاظ ملتهبة، ليغطيا به عن ضحالة تحليلهما، معتمدين على المساعدة الضمنية المتوارية التي تأتي من القوى السائدة في المجتمع.
حين يكره الاتجاه الانتهازي قوى المعارضة فهو يضخم أخطاءها بهدف الكسب من جهة أخرى.
وحين يضخم من أخطاء الحكومة فهو يهدف للتقرب إلى أتجاه آخر.
إنه لا يقدم تحليلاً موضوعياً يمكن عبره تطور الحالة السياسية وتغيير الظروف الاقتصادية دون أن يبالغ في الصواب أو الخطأ.
كما أن الحالة الدينية وأهميتها في حياة المسلمين تجعل بعض الاتجاهات تبالغ فيها، فجأة يصبح بعض الأشخاص المنافحين عن جماعة معينة من المسلمين ويقوم بالضخ التشنجي التعصبي فيها، بغرض إستغلالها واستثمارها لمصالحهم، وينبهر بعض البسطاء بهذه الحالة، فهم لا يتحدثون عن أخطاء هذه الاتجاه، بل يتعمدون ذكر فضائله من أجل أن يستغلوا هذا الشحن العاطفي لمصلحتهم.
وتتناقض مثل هذه الآراء الشخصية في كلها، فهم يمدحون هذه الاتجاهات في بلد بعيد، فإذا جاءوا لبلدهم انتقدوها!
وأقرب شيء لذلك هو مدح الزعماء وإستغلال أسماء الرموز، وجاءتنا فترة غثة سابقة أندفع بعض (المثقفين) فيها لتأييد شخصيات دكتاتورية فقط لمجرد إرضاء مشاعر عابرة هنا أو هناك!
لماذا يتركز المدح أو الذم على الأسماء الحادة في سياستها؟ !
فمثل هذه الشخصيات عرفت بالحدة في السياسة والتعصب وقيادة شئون البلدان إلى حافات الهاوية؟
لماذا لا تتوجه أفكارنا للتخفيف من حدتها من أجل الحفاظ عليها ومن أجل تطوير نهجها بدلاً من سيول المديح التي تفقدها الرزانة والعقلانية فتتوهم إن كل ما تفعله صواب؟! ومن البشري الذي لا يخطئ؟ !
لماذا لا نحافظ على هذه الشخصيات بشكل عقلاني نقدي فلا نضخمها ونحولها إلى آلهه!
وإذا كانت شخصيات دكتاتورية تمت إزالتها ينهمر عليها نفس المديح بغرض إيجاد بدال لها، وهي قد خربت ما خربته؟
ألسنا قادرين على تطوير النهج الإسلامي والنهج القومي بشخصيات موضوعية رصينة تدافع عن هذه الثوابت بشكل حديث ونقدي؟
هل عدمت الأمة إلا من شخصيات السحل والحرب والمحو للآخر؟
ولماذا تكون الشخصيات المعتدلة والزعامات البعيدة النظر والداعية للسلام هي في نظر هذه الكتابات والسياسات الانتهازية هي العدو؟
لماذا خلق هذا التشنج؟
العلمانية الانتهازية
تنبع الديمقراطية من احترام تقاليد الشعوب، وتشكيل أبنية تحديثة من داخل هذه التقاليد، تعكس مصالح الأغلبية الشعبية فيها، وهذه عملية مركبة، لأنها فيها احترام وصراع مع هذه التقاليد كذلك.
ومنها تصعب على القوى الانتهازية أن تشكل هذا الموقف المركب، فهي تأخذ جزءً منه، وتترك أجزاءَ أخرى.
فالعلمانية حين تغدو انتهازية تصبح تابعة للمذهبيين السياسيين في جانب سياسي جزئي، هو التماشي مع هدف المذهبيين في تكوين ديمقراطية سياسية، تقتصر على جوانب صغيرة من الحياة، هي تلك التي تتيح صعودهم السياسي وتحولهم إلى قوة دكتاتورية في المجتمع، وحينئذٍ يكون مثل التأييد والتصعيد خطراً على الديمقراطية!
لو كان هذا الصعود يترافق وعمليات ديمقراطية فقهية وتحرر للنساء ونمو ثقافة وطنية، وصعود للفلسفة، وللنقابات الحرة، لما كان هذا الصعود يمثل خطراً.
تغدو العلمانية هنا انتهازية، وليست موقفاً شاملاً، وتسلقاً على موجةٍ شعبية ملتبسة، تسيطرُ عليها قوى محافظة غير مدركة لتعقيدات الموقف وغير قادرة على مجاراة عملية تحرر المسلمين وتقدمهم، ومن هنا حين يحاول بعضُ القادة ركوبَ الموجة فإن مسائل ذاتية تتغلب عليهم هنا، ويغدو هدفهم الشخصي طاغياً على مستقبل المجتمع.
مثلما أن العلمانية التي تجعلُ أوراقَ التحديثِ والتحرر كلها بيد الغرب، تمثل موقفاً معاكساً، ومماثلاً في الجوهر.
إن المميزات المشتركة بين هذين النمطين من العلمانية هو غياب ذلك الموقف المركب، المرتكز على مصالح الأغلبية، وعلى جذور الكفاح لدى المسلمين والمسيحيين العرب وكل التراث السابق في المنطقة، حيث لا يمكن لهذه العلمانية إلا أن تنهض فوق تلك المصالح وذلك التراث، ولكن بشكل نقدي يعري طبقات التخلف واللامساواة والاضطهاد، ويجمع تلك الأغلبية في موقف نضالي مشترك واسع وعميق.
ومن هنا يغدو عزل الجوانب المحافظة والمتخلفة في المذاهب، وتطوير الجوانب العقلانية والديمقراطية والتوحيدية في التراث، ورفدها بإنتاج الإنسانية المعاصر الديمقراطي والإنساني، عملية سياسية بالغة الدقة، وموضوعية، لا تهدف إلى تسلط طائفة أو زعيم، بل تستهدف تجميع الناس التعاوني والخلاق لتشكيل وطن حر متقدم، يكرس كذلك احترام تقاليدهم ومذاهبهم وتطورها الحديث، بحيث أن لا تمثل تسلطاً على المجتمع أيضاً وعلى تنميته وتقدمه ووحدته.
ولهذا تحتاج العملية إلى سياسيين فقهاء علماء، أي سياسيين علمانيين إسلاميين شعبيين ديمقراطيين، في هذه العملية المركبة الدقيقة.
ومن هنا يغدو نفخُ جانبٍ واحد كالتعصب لمذهب، أو لجهة عالمية، تديناً ناقصاً، أو علمانية انتهازية، تكرس التخلف والتبعية لا التحرر والتقدم.
أسباب الانتهازية في اليسار
اليسار إلى عجزه الفكري عن التحليل، وفي الحياة السياسية تمثل تلك انتهازية من قبل القوى القيادية فيه، لمشاركة قوى الاستغلال في شيء من غنائم المال العام.
وهكذا يتم غض النظر عن جوانب والتركيز على جوانب، بهدف إظهار حسن النوايا سواء للإقطاع المذهبي أو السياسي، بحيث تبدو وجهة النظر المساقة متفقة مع نضال الشعب والديمقراطية والوطنية الخ، لكن من يطلقها يحسب حساباً طبقياً استثمارياً فهو يهدف لخدمة مصلحته.
حين يهاجم الدينيين بقسوة فهو يقصد هنا إظهار نفسه تحديثياً رسمياً وإنه يصلح للارتفاع إلى مقام الموظفين الكبار، وحين يهاجم الرسميين بقسوة مماثلة يريد مغازلة الدينيين لكي يصعدوه إلى مراتبهم العلية.
وتتشكل هنا أقسام جزئية أخرى داخلية ضمن هذا التعدد السياسي والطائفي المتنوع، فهذا يغازل طائفة وآخر يغازل طائفة وثالث يغازل جناحاً في السلطة وآخر يغازل جناحاً آخر، وخامس يغازل جناحاً في الجماعة المذهبية المنشقة وهكذا دواليك يقوم هؤلاء بجرنا إلى الخراب الطائفي..
وبدلاً من نشر الوعي الديمقراطي بين الناس كوعي أساسي يجري نشر الوعي الشمولي وتغليب العناصر الانتهازية..
إن الذين أيدوا إنجازات التحولات نسوا سلبياتها لأنهم قبضوا ثمن السكوت عن السلبي وركزوا على الإيجابي..!
والذين ركزوا على السلبي سرعان ما قفزوا لاستثمار إيجابياتها دون ذكر هذه الإيجابيات، لأن الجمهور الذي صنعوا وعيه على كراهية النظام لا يستسيغ مثل هذه القفزة البهلوانية!
وهو إذ يريد معارضة السياسة السائدة يريد تحولات في رواتبه ومساكنه وأحجام عمالته، لكن الذين يتسلقون على نضاله ومشاعره يريدون الوصول لأهدافهم الخاصة مع بعض البهارات النقدية.
وإذ استطاعت قوى اليمين أن تزيف تحركاتها الاستغلالية تحت غطاء كثيف من البخور الديني، لكن قوى اليسار تاهت ووضحت انقساماتها القائمة على الأهداف الذاتية، فشاركت في التقسيم الطائفي وتعميقه بين فئات الشعب المختلفة.
وصار الوصول للكراسي بديلاً عن إنتاج ثقافة سياسية ديمقراطية تحديثية توزع على كافة السكان، لأن التقلبات في السيرك السياسي كانت كبيرة لا تتيح خلق وعي، فيظهر موقف حاد ثم يعقبه موقف مناقض، ولا تردم الهوة بين الموقفين من خلال مواقف عقلانية صبورة في كل المواقف.
وهذا كله يفتت جبهة المعارضة وجمهورها الذي يبدأ بالانحسار والتشتت والتمزق وربما التضارب مستقبلاً!
وظهر هناك اتجاهان أساسيان في اليسار الاتجاه الأول هو اتجاه انتهازي، ويتوجه لدعم اليمين الديني، مقابل رشوة سياسية، واليمين الديني أثبت خواء تجربته السياسية سواء لدى المقاطعين أم المشاركين، بل وخطورة تسيده على القوائم والكراسي، لما يقود إليه من أخطار.
والاتجاه الثاني حائر متصارع متذبذب، بين حدة في الهجوم على التيارات الدينية اليمينية، وبين الخشوع لهجومها الخطر على التقدم الوطني.
والاتجاهان يكملان بعضهما، وه
عبـــــــدالله خلــــــــيفة : أسلوب الإنتاج الكولونيالي أو رأس المـــال الحـكومــــي الشـــــــــــــرقي
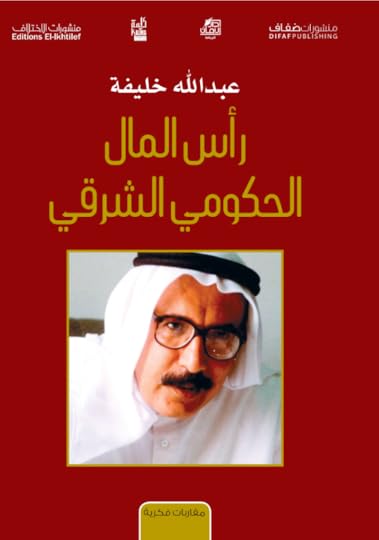
لا شك أن المفكر اللبناني الراحل مهدي عامل من المساهمين البارزين في تحليل الواقع العربي المعاصر من منطلقات نقدية عميقة وخاصة من رافد الماركسية البنيوية ، التي قام بتطبيقها على الواقع العربي بصورة حرفية ، دون رؤية الاختلاف بين مستوى التطور الغربي ، وتطور البُـنى الاجتماعية العربية .
ونحاول في هذه الموضوعات قراءة آرائه وتحليلاته لندوة جرت في الكويت في السبعينيات من القرن الماضي ، اتخذت لها عنواناً هو (أزمة التطور الحضاري في الوطن العربي) ، وقد ناقشها في كتابه : (أزمة الحضارة العربية أم أزمات البرجوازيات العربية ؟) .
يفترض مهدي عامل مسبقاً ، ودون دراسات ، بأن المجتمعات العربية هي مجتمعات رأسمالية . فهو يصر على أن ( نمط الإنتاج الرأسمالي المسيطر في البنيات الاجتماعية العربية) ، (9) .
إن هذا يبدو لوعيه شيئاً بديهياً ، صحيح إنه يقول أن ثمة علاقات ما قبل رأسمالية في هذا الإنتاج غير أنها ليست سوى بقايا .
فيقول بوضوح : إن فهم تطور بنية علاقات الإنتاج الرأسمالية مثلاً في البلدان العربية في الوقت الحاضر ، وفهم أزمات هذا التطور يستلزم بالضرورة الانطلاق بالتحليل من هذه البنية بالذات في شكل وجودها القائم في كل من البلدان العربية. ) ، (10) .
وليس ثمة من الضرورة بحث جذور هذه البُنى (مع ظهور الإسلام مثلاً ، أو مع الجاهلية ، أو مع بدء العصر العباسي أو الأموي أو الأندلسي أو عصر الانحطاط الخ . . ، بل هو يبدأ مع بدء التغلغل الإمبريالي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.) ، (11) .
وهو يعترف بأن ثمة (أشكالاً من الإنتاج سابقة على الإنتاج الرأسمالي لا تزال حاضرة في البنيات الاجتماعية العربية) ، غير أنها ليست سائدة فيه ، بل الإنتاج الرأسمالي هو السائد .
ونحن نحاول أن نفهم كيف استطاع الاستعمار أن يجعل من هذه العلاقات سائدة ؟ أي كيف استطاع أن يجعل العلاقات ما قبل الرأسمالية لا تسود بل أن تسود العلاقات الرأسمالية ؟
لا يقوم مهدي عامل ببحث هذه المسألة تاريخياً ، بأن يعطينا أمثلةً عن بلد عربي ومنذ القرن التاسع عشر تحول إلى الرأسمالية ؟ فلا نجد .
ولا أن يقوم بتحديد متى استطاعت البرجوازيات العربية أن تستولي على الحكم وتنشر النظام الرأسمالي الشامل ؟
ومن جهة أخرى فهو يؤكد بأن (كثيراً من علاقات الإنتاج الاجتماعية ، سواء في الحقل الاقتصادي أم السياسي أم الإيديولوجي ، التي تنتمي إلى أنماط من الإنتاج بالية ، أي بالتحديد ، سابقة على الرأسمالية ، لا تزال قائمة في البنيات الاجتماعية المعاصرة) ، (12) .
ينطلق مهدي عامل لتحديد هيمنة الرأسمالية على العالم العربي منذ القرن التاسع عشر بشكل مضاد للقراءة الموضوعية ، وهو يفترض رأسمالية سحرية تتشكل منذ أن تطأ بوارج بريطانيا وفرنسا الشواطئ العربية ، في حين إن الرأسمالية تتعلق بمدى تشكل الرأسمال الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة ، ومدى انتشار العمل المأجور على بقية أنواع العمل في النظام الاجتماعي .
وتتحددُ سيطرةُ البنيةِ الرأسماليةِ بوصولِ منتجي البضائع إلى سدة الحكم ، وإزاحة ملاك الأرض وإقطاعيي السلطة السياسية ، وسيادة العمل بالأجرة ، وهي كلها أمور لم تتحقق في نهاية القرن التاسع عشر ولا في نهاية القرن العشرين العربيين !
ولكن مهدي عامل يُصادر ببساطة ، قبل أن يبحث ، فهو منذ البدء يقول: (أزمة البرجوازيات العربية. .) فأفترض إن هذه البرجوازيات قد حكمت وتعفنت في الحكم وهي مأزومة الآن؟! في حين إن البناء الاقتصادي والسياسي لم تتحقق فيه شروط انتصار الرأسمالية !
ولكن ذلك لا يتعلق فقط بالبحث الفكري بل والأخطر بالمهمات السياسية المباشرة ، فيقول بأن :
(المهمة الأساسية لحركة تاريخنا المعاصر بهذا الشكل ، لاتضح لنا أن تحققها يمر بالضرورة عبر عملية معقدة من الصراع الطبقي ضد البرجوازيات العربية المسيطرة . .) ، (13) .
ولكن كيف يمكن إسقاط أسلوب إنتاج لم يُسد وطبقات لا تحكم ؟
علينا أن نناقش مسألة أسلوب الإنتاج الكولونيالي التي طرحها مهدي عامل ، كي نقوم بتفكيك تفكير هذا المفكر ، وهي التي اعتبرها حجر الزاوية في نظريته حول تطور العالم العربي .
كما رأينا سابقاً ، (راجع الفقرة حول التاريخ العربي) إن مهدي عامل يرفض تحليل البنية الاجتماعية العربية الحالية من خلال جذورها ، وهو ينتقد المفكرين العرب المجتمعين في الكويت لمناقشة (أزمة تطور الحضارة العربية) بسبب قيامهم بالعودة إلى جذور التاريخ العربي ، طالباً الوقوف عند العصر الراهن والنظر إلى الماضي من خلال البنية الاجتماعية الراهنة .
إن مهدي عامل ينظر للبُنى الاجتماعية العربية الراهنة وكأنها صياغة أوربية غربية ، فقد قام الاستعمار الغربي برسملتها ، أي بتحويلها إلى رأسمالية ناجزة ، وهذه الرأسمالية الناجزة يُطلق عليها أسم ( أسلوب الإنتاج الكولونيالي ) ، وبهذا قام مهدي بخطئين كبيرين مزدوجين ، فهو قد قطع السيرورة التاريخية للبُنى العربية الاجتماعية ، أي قام بإزالة طابعها الطبقي التاريخي ، وهي عملية يقوم فيها بالتمرد على القوانين الموضوعية لرؤية المادية التاريخية عن التشكيلات الخمس: المشاعية ، والعبودية ، والإقطاع ، والرأسمالية ، والاشتراكية.
فهو عبر هذه المقولة قد ألغى كون البُنى الاجتماعية العربية بُنى إقطاعية ، فحين لا نبحث ألف سنة من التطور الاقتصادي والاجتماعي السابق ، ونعتقد أن أسلوباً جديداً للإنتاج قد تشكل ، وأسمه الأسلوب الكولونيالي ، في خلال بضع سنين ، وأن علينا أن ننظر للتاريخ من خلال هذا الأسلوب غير المحدد والغامض ، فتتشكلُ لدينا هنا رؤيةٌ سياسية دكتاتورية تحاول أن تفرض نفسها على جسدِ التاريخ الموضوعي ، بمعطيات غير مدروسة .
إن رفضَ تحليل الماضي ، أي رفض بحث التاريخ الإقطاعي للعرب ، يتضافرُ لدى مهدي عامل ، ورفض تحليل الحاضر ، أي قراءة عمليات التداخل بين الإقطاع والرأسمالية ، كأسلوبين للإنتاج موضوعيين في التاريخ العربي الراهن ، ويطالب بمناقشةِ أسلوب إنتاج من اصطلاحاته هو أسلوب الإنتاج الكولونيالي .
ومع هذا فعلينا أن نناقش تسمية أسلوب الإنتاج المقترح ، فمهدي عامل لا يُنكر وجود بقايا نظام تقليدي في هذا الأسلوب الذي انتصرت فيه العلاقات الرأسمالية ، ودون أن يطرح أية أرقام أو معطيات على انتصار العلاقات الرأسمالية الموهومة ، لكنه يعتبر إن العلاقات الرأسمالية المنتصرة في العالم العربي تشكل علاقة تبعية مع العالم الغربي حيث العلاقات الرأسمالية الأقوى ، وهذه الأخيرة الغربية هي التي تقوم داخلها بتقويض أساليب الإنتاج الأخرى ، في حين تعجز الرأسمالية العربية في علاقتها التابعة من تقويض أساليب الإنتاج السابقة داخلها ، وبهذا فإن أسلوبَ الإنتاج الكولونيالي الذي سادت فيه البرجوازياتُ العربيةُ يحتاج إلى ثوراتٍ عمالية لتقويضه والانتقال إلى الاشتراكية .
تتشكلُ هذه العمومياتُ الفكريةُ من منهجٍ مجردٍ يفرضُ قوالبه على الواقع الحي غير المدروس ، فتـُـلغى مسألةُ التشكيلة الإقطاعية بجرة قلم ، ويتم تحويلها إلى تشكيلة أخرى متطورة بقفزة خيالية أخرى هي التشكيلة الرأسمالية الكولونيالية ، ثم تحدث القفزة الأكبر إلى الاشتراكية . . ولا يزال الباحث لم يحلل الإقطاع العربي وسيرورته السابقة والراهنة .
والغريب إنه في كتابه هذا (أزمة الحضارة العربية . .) يناقش جملةً من المفكرين العرب الذين يقدمون له مادة تحليلية ممتازة ، ولو أنه أبعد فرضياته الإيديولوجية المسبقة ، أو استفاد بعمق من الماركسية البنيوية التي نقل تطبيقاتها لفهم البنية الاجتماعية ، لأمكنه أن يدخل إلى دائرة التاريخ العربي وتشكيلته التي تضاربت أسماؤها لديه . ولكنه حدد منذ البدء هؤلاء الباحثين كمنظرين للبرجوازيات العربية المستولية على الحكم والتي وصلت إلى الأزمة ، وبالتالي يجب نقد وعي هذه الطبقات المسيطرة عبر وعي الطبقات الثورية الخ . .
حين يناقش مهدي عامل الباحث العربي شاكر مصطفى يتجاهل مهدي المادة الفكرية الثمينة التي يقدمها شاكر لتوصيف تطور المجتمعات العربية بقوله :
(إن الاستمرار الاجتماعي الذي تعيشه الشعوب العربية إنما تحكمه عناصر عديدة في مجموعها التركيب العربي القائم . . وأن لامتدادات التاريخ في هذه العناصر المكان الواسع إن لم يكن الأول. .) وهذه (العناصر الأساسية الباقية عند أربعة جوانب :
أ ــ طرق الإنتاج المادي ب ــ تكوين نظام السلطة ج ــ طبيعة العلاقات الاجتماعية د ــ قيم الفكر التراثية..)، (14) .
هكذا نرى لدى شاكر مصطفى نظرة تاريخية موضوعية واقتراباً دقيقاً من فهم أسلوب الإنتاج الإقطاعي العربي الإسلامي المستمر عبر ألف سنة ، الذي يتأسس في نظام السلطة والإنتاج معاً ، ثم يتمظهرُ في العلاقات الاجتماعية : الأبوية ، هيمنة الذكور ، اللامساوة الجنسية ، الطائفية الخ . . ثم يصل النظام الإقطاعي إلى المستوى الثقافي : الأمية ، الخرافة الخ . .
إن شاكر مصطفى يمثـل مقاربة علمية (ماركسية) من فهم التاريخ ، ولكن ماذا يفعل مهدي عامل بمثـل هذه المقاربة ؟
بدلاً من أن يقوم بفهمها ودرس التاريخ العربي يقوم بالمصادرة السريعة ، فيقول :
(أما أن يكون هذا التاريخ الذي تكونت فيه البنية الاجتماعية للواقع العربي الحاضر ، تاريخاً يرجع إلى ما قبل عشرة قرون خلت ، أي إلى العصر العباسي أو أواخر العصر الأموي ، فهذا ما نختلفُ فيه جذرياً مع الدكتور مصطفى ) ، (15) .
فهو يحتار كيف أن هذه البنية المزدهرة يوماً ما تصبح هي نفسها سبب التخلف ؟ فيقول بلغته :
(فالبنية هذه ليست في حاضرها ، من حيث هي بنية ، أي كلٌ معقد متماسك ، سوى البذرة التي كانتها في الماضي ، تنامت ، فتنافت وتواصلت في حركة من تماثـل الذات بالذات ، وما الذات هذه إلا الذات العربية نفسها . ) ، (16) .
إن مهدي عامل الذي ينتقد شاكر مصطفى على أنه صار يفكر بمنهج هيجل الجدلي المثالي ، يعجز عن اكتشاف رؤية الوعي الموضوعي لدى مصطفى شاكر في فهمه للتاريخ العربي ، ويصبح هو هيجلياً مثالياً.
فالبنيةُ العربيةُ الإقطاعية في زمن الإمبراطورية العباسية كانت نظاماً مركزياً ، والإقطاع المتحكم في الخراج الهائل يصرفه على البناء الترفي والثقافة المقربة المفيدة للنظام ، ثم يتحلل هذا الإقطاع المركزي بسبب ثورات الشعوب ، ليجيء نظام الإقطاع اللامركزي ، وتظهر الدول والدويلات الإقطاعية ، وتكرر بشكل أوسع إنجازات ومشكلات النظام السابق ، ثم يتهرأ هذا النظام الإقطاعي الديني العام بتشكيلاته المتعددة ، ليغدو أنظمة وإمارات إقطاعية صغيرة مذهبية الخ . .
إن هذه السيرورة التاريخية تحافظ على قسمات عامة أشار لبعضها شاكر مصطفى في المقطع السابق ذكره، حيث يغدو الحكام هم المستولون على القسم الأكبر من الثروة العامة ، وتتواشج السلطة والثروة ، ويشركون رجال الدين في السيطرة على العلاقات الاجتماعية ، أي ينقلون العلاقات الإقطاعية إلى البيوت والأحوال الشخصية الخ . .
وإذا لم نقم كما يريد مهدي عامل بقراءة هذه السيرورة التاريخية الاجتماعية التي امتدت خلال ألف سنة ، والتي تتغلغل في أبنيتنا الاجتماعية وقوانينا الوراثية وفي سلطاتنا المطلقة، وفي شعرنا ونثرنا وعاداتنا ولاوعينا ، فكيف نقوم بتغيير هذه البنية التقليدية وتشكيل النهضة ؟ !
إن مهدي عامل يخرق قوانين الوعي على مستوى قراءة الماضي ، وعلى مستوى قراءة الماركسية ، فعبر قراءة الماضي يتجاهل البنية الإقطاعية وسيرورتها الراهنة ، وعلى مستوى الماركسية يقوم باختراع مغامرات سياسية محفوفة بالكوارث ، عبر اختراعه مقولة أسلوب الإنتاج الكولونيالي وتصفية البرجوازيات العربية .
فهو بدلاً من قراءة الماضي ورؤية أسباب عجز البرجوازيات العربية القديمة عن تشكيل النهضة ، والقيام بثورة رأسمالية ، وقراءة أسباب ضعف البرجوازيات العربية الراهنة وعدم قدرتها على تغيير أسلوب الإنتاج الإقطاعي وتشكيل تحالف معها لتغيير التركيبة التقليدية يقوم بوضعها في خانة العدو والقفز ضدها إلى مهمات غير حقيقية ومكلفة كما دلت تجربة الشعب اللبناني .
يمثـل المفكرون الذين تواجدوا في الكويت لمناقشة مسائل النهضة العربية وكيفية إيجادها ، نخبة اشتغلت في حقول الدراسات لزمن طويل ، وبغض النظر عن اجتهاداتها ومدارسها فإنها تعبر عن عقول مهمة تعارض المجتمعات العربية التقليدية من منطلقات مختلفة ، لكن المفكر اللبناني مهدي عامل نظر إليها كخصوم وليس كقوى مساندة للطبقات العاملة العربية في تغيير مجتمعات التخلف ، وبهذا كان يرفض العديد من الآراء المهمة التي تقدمها كما فعل مع مصطفى شاكر .
ويعترض مهدي عامل كذلك على زكي نجيب محمود الذي يمثل المدرسة الوضعية أو التجريبية المنطقية في دعوته لأحكام العقل في النظر إلى الأشياء ، وخاصة في جملته التي قالها بضرورة (الاحتكام إلى العقل في قبول ما يقبله الناس وفي رفض ما يرفضونه) ، ودعا زكي نجيب العربَ إلى التوجهِ لتمثل الحضارة المتقدمة ، واعتبر إن الاحتكام إلى العقل ميز الحضارات العقلانية ، معطياً نماذج أربعة على حضارات احتكمت إلى العقل وهي :
أثينا في القرن الخامس قبل الميلاد ، وبغداد في عصر المأمون ، وفلورنسة في القرن الخامس عشر ، وباريس في عصر التنوير في القرن الثامن عشر .
أي إن زكي نجيب يقدم درجات من صعود البرجوازية عبر العصور ، أعطى إنتاجها المادي قدرة على الفهم الموضوعي للطبيعة المجتمع ، على درجات متفاوتة .
ويعترض مهدي عامل على هذه التصنيفات ويقول :
(وهنا تظهر الدلالة الطبقية لهذا المنطق من التفكير : فانتفاء الطابع التاريخي ، أي النسبي ، من شكل العقلانية الخاص بالبنية الاجتماعية الرأسمالية يجعل من هذا الشكل الخاص مطلقاً ، فيظهر ما هو تاريخي – أي ما يحمل فيه ضرورة تخطيه ونفيه – بمظهر ما هو طبيعي – أي يحمل فيه ضرورة تأبده – ويظهر الشكل الطبقي البرجوازي للعقلانية بمظهر العقلانية الإنسانية ، أي بما هو طبيعي ملازم للحضارة كحضارة . .) ، (17) .
إن فئاتٍ برجوازيةً عربية تعاني من هيمنة تقليدية متخلفة ، وحين تقوم باستعادة لحظات من فعل الفئات المتوسطة عبر التاريخ الماضي إنما تريد شحذ عقلها وإرادتها من أجل تشكيل عالم نهضوي عقلاني عربي ، يمكن حتى للقوى الشعبية فيه أن تناضل بصورة حديثة ، لكن زكي نجيب محمود هنا يفصل العقلانية عن أسلوب الإنتاج ، ولا يرى إن العقلانية في أسلوب إقطاعي (عباسي) هو غيره في أسلوب رأسمالي جنيني في أوربا ، وبالتالي كان هذا يحتاج لقراءة العنصر العقلاني في سيرورته التاريخية .
إن النموذج الذي يختاره مهدي عامل في الفصل الرابع من الكتاب السابق الذكر ، هو الشاعر والباحث أدونيس ، الذي صاغ دراسة حول الإمام أبي حامد الغزالي في ذلك المؤتمر مُستنتجاً ــ أي أدونيس ــ بأن الفكر الديني :
[بقواعده وغاياته ، هو الذي يسود المجتمع العربي ، اليوم . ولذلك فإن الإيديولوجية السائدة ، سواء في المدرسة والجامعة والبرامج التربوية ، والصحافة والإذاعة والكتاب ، إنما هي قوة ارتداد نحو الماضي ، وقوة محافظة على الراهن الموروث . . فعلاقات الإنتاج الموروثة . . ما تزال هي السائدة . . والبنية الإيديولوجية التقليدية . . ما تزال كذلك هي السائدة] ، (18) .
هذا الكلام يقوله أدونيس في سنة 1974 ، وبالتالي استطاع أن يشخص الواقع العربي تشخيصاً مهماً بحيث أننا الآن (سنة 2005) ندرك الفجائع المترتبة على هذه السيادة الماضوية . ولكن اليسار حينذاك لم يكن ير مثل هذا التشخيص ، كرفيقنا الراحل مهدي عامل ، الذي يتصدى لهذه المقولة قائلاً رداً وتحليلاً للرأي السابق :
[1 – الفكر العربي هو نموذجه ، ونموذجه هو الغزالي ، فالفكر العربي إذن هو فكر الغزالي .
2 – الفكر السائد في الماضي هو الفكر السائد في الحاضر .
3 – البنية الإيديولوجية السائدة في الماضي هي البنية الإيديولوجية السائدة في الحاضر.
4 – علاقة الإنتاج المتوارثة – أي السائدة في الماضي – هي علاقات الإنتاج القائمة في الحاضر .
إذن الماضي هو هو الحاضر ، لا شيء تغير. (خلاصة).] ، (19) .
من الواضح إن مهدي عامل يقوم بتبسيط نظرة أدونيس إلى التاريخ الفكري العربي ، فالغزالي لدى أدونيس هو كل الفكر العربي الديني المحافظ ، ولكن أدونيس يقول إن هذا الفكر المحافظ المذهبي هو الذي ساد ، وإذا طورنا مقولة أدونيس كما توصلنا إليها ، فنقول إن رؤية الغزالي كانت هي ثقافة الإقطاع السائد . ولكن ثقافة الإقطاع المذهبي متعددة ، وحتى تسود قامت بالقضاء على التيارات الدينية المعارضة ، وهذه لها حراك وصراع استمر إلى وقتنا الراهن ، فليس معنى ذلك سكون الخريطة الفكرية الاجتماعية ، بل أن لها ألواناً وتضاريس معقدة . ولكن من الناحية الجوهرية فإن المنظومة العربية الإسلامية لم تخرج عن التشكيلة الإقطاعية ، ومعرفة وتحديد التشكيلة هذه هي الخطأ الجوهري لدى مهدي عامل كما بينا سابقاً ، في حين أن الباحثين المنبثقين من الفئات الوسطى الحديثة كأدونيس وشاكر مصطفى ، يرون أنها مستمرة ، لكنهم لا يعرفون كيف يبلورن ذلك نظرياً .
يضع مهدي عامل بعض ممارسات الفلاسفة العرب كابن رشد في دائرة ما يسميه [بالممارسة الإيديولوجية لما يمكن تسميته بالطبقة الأرستقراطية العربية المسيطرة في المجتمع الاستبدادي في القرون الوسطى.] ، وبغض النظر عن جمله من المفاهيم الخاطئة في هذه العبارة ، فإن مهدي عامل يضع الممارسات النقدية للمفكرين العرب المسلمين السابقين في سياق [مجتمع استبدادي] ، وليس في سياق التشكيلة الإقطاعية المعروفة بداهةً للمادية التاريخية ، ثم يقوم بوضع الحركات والفكر الديني الإسلامي المعاصر في سياق آخر فيقول :
[أما في الحالة الثانية ، «فالإسلام» موجود بالشكل الذي يتحدد فيه بحقل آخر من الممارسات الإيديولوجية الطبقية ، خاص ببنية اجتماعية مختلفة ، يغلب عليها الطابع الكولونيالي، في انتمائها التاريخي إلى نمط الإنتاج الرأسمالي .] ، (20) .
إن هذه البنية الحديثة التي يضع مهدي عامل الوعي الديني السابق فيها ، هي بنية يغلب عليها (الطابع الكولونيالي وتنتمي تاريخياً إلى نمط الإنتاج الرأسمالي) ، وهي توصيفات نرى كيف أنها بذاتها قلقة مضطربة ، وهو يلجأ إلى كلمة (كولونيالي) الأجنبية المنتفخة ، لكي يُشعر القارئ بأنها مصطلح غني في حين يمكن القول بأن البنية العربية هي بنية تابعة ، ووجود التبعية لا يخلق تشكيلة جديدة ، أي أنه حين تقوم الرأسمالية المسيطرة غربياً بإلحاق البلدان الفقيرة الإقطاعية في العالم الثالث باقتصادها ، فإن هذه البنية التابعة تظل في تشكيلتها الإقطاعية السابقة ، لأن الاستعمار لا يقوم بثورة اجتماعية فيها بحيث يحولها إلى نموذجه أو نموذج الرأسمالية ، بل يبقيها في بنيتها السابقة ويجري تغييرات سياسية واقتصادية بحيث تقوم بضخ المواد الأولية إليه وتغدو سوقاً لمنتجاته الخ . . لكن عمليات الإلحاق والتغيير الرأسمالية المحدودة تكون في إطار التشكيلة الإقطاعية ، أي أن التشكيلة السابقة لم تتبدل بثورة تبدل البناءين ؛ التحتي بثورة اقتصادية ، والبناء الفوقي بثورة ثقافية ، بل جاءتها عناصر رأسمالية فقامت باستيعابها في قوانين التشكيلة الإقطاعية التقليدية .
إذن عدم فهم مهدي عامل للقضية المحورية وهي قضية التشكيلة يقوده إلى سلسلة من الأخطاء اللاحقة ، حيث ينفي كون الدين أيديولوجية فكرية مسيطرة في الحاضر ، لأنه نفى كون التشكيلة المعاصرة تشكيلة إقطاعية ، وبهذا لم يُدرك المهمات الفكرية والسياسية الأساسية الراهنة ، وهي تغيير التشكيلة وبناءها الفكري التقليدي .
ولهذا يقوم بنقد أدونيس لأنه يقول باستمرار التشكيلة الإقطاعية ووعيها الديني الأساسي ، (ويجب أن نقول هنا وعيها : المذهبي السياسي) ، منتقداً إياه بأنه ينقل :
[مركز الثـقل في الممارسة الإيديولوجية للصراع الطبقي ضد البرجوازية المسيطرة ، من صراع ضد إيديولوجية هذه الطبقة ، بمختلف تياراتها ، إلى صراع ضد الشكل الديني أو الطابع الديني من هذه الإيديولوجية..] ، (21) .
وهنا يواصل مهدي عامل عدم فهمه وخلطه للأمور ، فأدونيس في نقده للشمولية الدينية ينقدها في ظل نظامها التقليدي الإقطاعي ، أي باعتبار الوعي الطائفي المحافظ تجلياً فكرياً واجتماعياً للممارسة الإقطاعية المهيمنة على المسلمين (والمسيحيين) ، وليس باعتبارها نضالاً ضد الشكل الديني ، أي بأنها قضية فك علاقة الدين بالسيطرة السياسية والاجتماعية الإقطاعية الراهنة ، وتشكيل منظومة سياسية حديثة علمانية .
أي أن مهدي عامل يريد تجيـير النقد ضد الدين ، ويجعله بإطلاق ، وليس ضد الوعي السياسي الطائفي المستغل للإسلام في تأبيد البنية الإقطاعية المتخلفة ، وبالتالي يريد توجيه الوعي الفكري ضد البرجوازية العربية الحديثة ، باعتبارها سبب الأزمة والعائق ، أي أنه في النهاية يقوم بالدفاع غير المباشر عن الإقطاع الديني ، أو أنه بالهجوم على البرجوازية الحديثة يفتت الصفوف الموجهة ضد الإقطاع الديني والسياسي .
فلنحلل أكثر التباس المفاهيم والمراحل واستراتيجيات النضال لدى مهدي عامل .
يقول :
[ فالعلاقة هذه التي تمنع تطور الإنتاج الرأسمالي ، في شكله الكولونيالي ، من أن يميل ، في قانونه العام ، إلى القضاء على علاقات الإنتاج السابقة عليه ، في سيطرته بالذات عليها ، هي نفسها العلاقة التي تمنع البرجوازية الكولونيالية ، في ممارسة سيطرتها الإيديولوجية / من القضاء على مختلف الإيديولوجيات السابقة على الإيديولوجية البرجوازية ، في سيطرتها بالذات ..] ، (22) .
يعتمد مهدي عامل على منطق ارسطي شكلاني يجرد التاريخ من سيرورته الحقيقية ، ويضعه في قوالب لا تاريخية ، أي لا توجد إلا في وعيه الذي يقع خارج التاريخ الحي .
فهو أولاً قد أثبت انتصار الإنتاج الرأسمالي في العالم العربي ، في القرن التاسع عشر كما سيقول لاحقاً أيضاً ! لكن هذا الانتصار تم في إطار كولونيالي ، ورغم إن البرجوازيات العربية التي انتصرت على أشكال الإنتاج ما قبل الرأسمالية قد انتصرت إلا أنها مع ذلك تحافظ على الأيديولوجيات ما قبل الرأسمالية وهو ذات السبب الذي يجعلها تحافظ على أساليب الإنتاج ما قبل الرأسمالية !
فأولاً حين جاء الاستعمار إلى العالم العربي في القرن التاسع عشر ، كرس الإقطاع والطائفية والأمية ، ولم تستطع الفئات الوسطى (البرجوازية) أن تنمو إلا بشق النفس ، وخاصة الفئة الصناعية ، وبقيت الأبنية الاجتماعية تسود فيها عبودية النساء وعدم خروجهن للعمل والإنتاج، وهيمنة الإقطاع الطائفي الخ . .
وبهذا فإن نضالات الفئات الوسطى كانت تتحدد في كل بنية اجتماعية عربية ، حسب تطورها الاقتصادي الاجتماعي ، فإن تنمو فئة وسطى وتقود نضالاً ديمقراطياً كان ذلك يحتاج إلى عقود ، وليس كما يظهر في وعي مهدي عامل ، بشكل أزرار سحرية ، وكأن تشكل علاقات الإنتاج الرأسمالية تتم في الذهن وليس في الواقع الحي . أي أن الرأسمالية تحتاج إلى شروط موضوعية وهي انتشار الصناعة وانتشار العمل بالأجرة وتحرر النساء الخ . .
ولو افترضنا جدلاً بنشؤ الرأسمالية الواسعة في نهاية القرن التاسع عشر ، وهذا محض خيال ، فإن أشكال الوعي الدينية ، المرافقة للتشكيلة الإقطاعية ، لا تنهار بسهولة كبيت من ورق .
إن الوعي الديني المترافق مع التشكيلة الإقطاعية العربية تأسس فوق بنية زراعية / حرفية / رعوية ، وداخل صراعات اجتماعية (قومية) ومناطقية ، وقادته الصراعات السياسية الاجتماعية إلى الانقسام المذهبي الكبير في عصر الثورة والمعارضة ، بين التيارات المحافظة والتيارات المعارضة ، بين التيارات الإقطاعية الناجزة وتيارات الفئات الوسطى الفاشلة ، ثم إلى الانقسام المذهبي الكبير الثاني حين انتصرت التيارات والدول المحافظة ، أي الانقسام بين السنة والشيعة .
إن هذه السيرورة الاجتماعية الإيديولوجية المتلونة بمراحلها وآثارها لا يمكن أن تزول آلياً مع الانتصار الموهوم للرأسمالية كما يظن مهدي عامل ، بل إن هذا البناء الفوقي يحتاج إلى قرون لكي تتم زحزحة خطوطه المتكلسة ، ولكن الأمر أعقد من ذلك لأن هذا البناء الفوقي يتأسس تحت بناء قاعدي لم يتغير كثيراً.
وكما أوضح شاكر مصطفى في عبارته الهامة التي اقتطعاها مهدي عامل ورفضها ، بأن النظام الإقطاعي العربي الديني تتداخل فيه مسألتي السلطة والُملكية ، أي تتواشج فيه جوانب من البناءين التحتي والفوقي ، فالمسيطرون على الثروة والملكية العامة والأوقاف الخ . . هم الإقطاعيون السياسيون والدينيون ، وهو أمر يتمظهر مذهبياً في البلدان ذات المذاهب المتنوعة ، ودينياً في الأقطار الإسلامية ذات الاختلاط مع المسيحية ، وهذه الهيمنة الإقطاعية تظهر على شكل مَلكيات استبدادية وهو أمر استمر حتى منتصف القرن العشرين في بعض الدول العربية وليس في أغلبها ، وعلى شكل جمهوريات رئاسية أو ملكيات لم تستطع أن تـُنجز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية المكتملة ، أي في جميع الأقطار العربية الإسلامية حتى الوقت الراهن .
يحكم مهدي عامل على البرجوازيات العربية منذ تشكلها وصراعها ضد الإقطاع والاستعمار ، بحكم سياسي واحد ، فبعد أن شكلها بشكل ناجز في ذهنه فحسب ، وبعد أن شكل الأنظمة الرأسمالية العربية في وعيه فحسب ، غدت متطابقة مع البرجوازية الاستعمارية المسيطرة وبالتالي غدت منذ البدء عدواً .
لهذا فإنه لا يقرأ سيرورتها الفكرية والاجتماعية وبالتالي مراحل تطورها ومن هنا لا يرى فرقاً بين (ما نراه في أيديولوجيتها من مفاهيم «عصرية» ليبرالية ، وما نراه أيضاً في بدء «تاريخها الإيديولوجي» من مفاهيم أرادت أن تكون مثيلة مفاهيم الثورة الفرنسية البرجوازية ، كما هو الأمر عند رفاعة الطهطاوي ولطفي السيد وغيرهما) ، (23) .
ومهما كانت عدم الدقة في المطابقة بين آراء الثورة الفرنسية وآراء الطهطاوي ولطفي السيد ، فإن عدم رؤية أهمية آراء المنورين العرب في ذلك الكهف الإقطاعي التي كانت ولا تزال الشعوب العربية تحاول الخروج منه ، فذلك يدل على وعي الأرادوية الذاتية (الثورية) في إلغائها للقوانين الموضوعية للتطور الاجتماعي ، مثلما تفعل في مسألة الوعي بالتشكيلة وبالوعي المهيمن فيها ، حيث يلغي مهدي عامل أهمية أفكار البرجوازية النهضوية ويثبت آراء الإقطاع الديني ، فيقول بأن الإيديولوجية الدينية :
(ليست هي الإيديولوجية المسيطرة ، أو التيار الإيديولوجي المسيطر في الإيديولوجية المسيطرة ، أو أيديولوجية البرجوازية الكولونيالية المسيطرة ) ، (24) .
إذن إنه في عدم وعيه بسيرورة الإقطاع السياسي الديني في الماضي : بقوانين تشكله وصراعاته وظهور الفئات الوسطى بين أشداقه وأسباب انهيارها وغلبته ، فإن مهدي عامل لا يرى قوانين استمراريته وانهياره في العصر الحديث العربي ، وأسباب ضعف الفئات الوسطى ، وصراعها معه ومع الاستعمار.
إن عدم رؤية قوانين البنية الاجتماعية في الماضي ، هي ذاتها تتجلى في عدم رؤية قوانينها في الحاضر ، ويقود ذلك إلى عدم رؤية قوانين التشكيلة الإقطاعية عامة ، خاصة عملية تفكيكها وتغييرها المعاصرة ، وإذا أحلنا آراء مهدي عامل الفكرية العامة إلى الميدان السياسي ، فيعني ذلك تقوية الإقطاع .
فعدم تثمين مقاومات الفئات الوسطى في الماضي والحاضر ، وتشكيل جبهة سياسية تحديثية واسعة ، تراكم الوعي النهضوي وتقود في الخاتمة إلى الثورة أو القطع مع المنظومة الإقطاعية ، واستبدالها بمنظومة حديثة ، يعني تصفية القوى النهضوية وتفكيكها ، وبالتالي تصعيد الإقطاع في مستويات البنية المختلفة .
علينا أن نرى إن ثمة عدم دقة تحليلية للإقطاع المذهبي وتطوره في التاريخ العربي لدى أدونيس كذلك ، أي أن أدونيس لا يرى الجذور الاجتماعية لتشكل الحداثة قديماً وحديثاً ، التي تؤسسها الفئات الوسطى العربية ، ولكنه يقترب من هذا التحديد بشكل أفضل من مهدي عامل، الذي يقول عن ذلك :
(لكن المنطق الذي قاد أدونيس إلى عدم رؤية هذا الطابع الطبقي المميز للصراع الإيديولوجي في واقعنا الراهن ، هو تلك المعادلة الرابعة التي أقامها بين علاقات الإنتاج السائدة في الماضي وعلاقات الإنتاج القائمة في الحاضر. .) ، ويضيف مهدي عامل : (أما أن تكون هذه العلاقات الموروثة نفسها هي هي العلاقات القائمة حالياً ، فهذا ما لا يمكن للمنطق العلمي أن يقبل به ، برغم وجود الانسجام الداخلي في منطق أدونيس..) ، (25) .
ومن المؤكد إن الإقطاع العربي الكلاسيكي القائم على ملكية الأرض الزراعية والخراج ، لم يعد شاملاً ، لكن مهدي عامل لم يقم بدرس العلاقات الاقتصادية العربية الحديثة ، وكيف أن ملكية الدولة لوسائل الإنتاج تمثل شكلاً إقطاعياً حين تغدو تابعة بالوارثة لأسرة أو جماعة سياسية ، بدلاً من أن تكون هذه الوسائل بضاعة متداولة ، ولهذا ثمة استمرارية كبيرة بين حقول النفط وحقول الزراعة ، وبين الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تتركها في تقوية الإقطاع الأسري والحزبي الخ . . ونعرض ذلك كمثال عابر فقط ، من أجل أن نرى استمرارية الحياة التقليدية ، وبالتالي فإن الحكم العام الذي يطلقه أدونيس باستمرار الوعي التقليدي وهيمنته لا يجانب الصواب .
إن أدونيس إذن عبر تلك الفقرة التحليلية يقربنا من رؤية البنية الحقيقية للحياة العربية ، فيما يعمل مهدي عامل على إخراجنا من تلك البنية وإدخلانا في بنية موهومة من قراءته ومعايشته للحياة الغربية ، فيريد نقل مهمات الصراع الطبقي فيها، إلى بلدان متخلفة ، تشكو من قلة البرجوازية والعمال والتصنيع ، دون أن يحاول العودة إلى مصادر أدونيس في قراءة المجتمعات العربية ، في كتابه (الثابت والمتحول) خاصة .
في إحدى الفقرات من كتابه (أزمة الحضارة العربية أم أزمة البرجوازيات العربية؟) ، يقر مهدي عامل ضمناً بسيادة العلاقات الإنتاجية والاجتماعية التقليدية وهو يرد على أدونيس فيقول :
(إن وجود هذه العلاقات السابقة في البنية الاجتماعية الكولونيالية لا يعني أنها العلاقات السائدة في هذه البنية ، حتى وإن كانت هي تنتشر على القسم الأعظم من السكان ، كما هي الحال في الهند مثلاً، أو في كثير من البلدان العربية . .) ، (26) .
إنه يعتبر الإنتاج التابع شكلا تاريخياً محدداً من الإنتاج الرأسمالي ، فمهما كانت الأشكال ما قبل الرأسمالية منتشرة فإن ما يحدد توجه التطور هو النمط الرأسمالي . وبطبيعة الحال لا يمكن أن نأخذ بهذه الجمل إلا عبر تحليل للأبنية الاقتصادية الاجتماعية المحددة في كل بلد ، فرغم أن التطور الرأسمالي هو تطور عالمي عاصف ، إلا أن كل منطقة وبلد لهما خصوصياتهما ، أي أن الأمر يعود لتطور التشكيلات وتاريخها ، وتناقضاتها الداخلية ، فالتشكيلة الإقطاعية العربية الإسلامية ، عبر سيطرة مختلف الدول الاستعمارية على أقطارها المتعددة ، لم تقم هذه الدول الاستعمارية برسملتها بشكل شامل ، وحتى بعد مختلف الثورات الوطنية فإن المسألة الديمقراطية لم تـُحل ، أي أن هذه الأنظمة ظلت على بنياتها الإقطاعية المذهبية ، وظلت الدولة طائفية واللامساواة بين المواطنين سائدة ، وظلت قوى ما قبل رأسمالية تتحكم في الثروة العامة الخ . .
لكن مهدي عامل لا يرى ذلك ، بل يرى إن هذه الأنظمة أنظمة رأسمالية فيجب أن :
(يرفض الدولة البرجوازية ، أي هذا الشكل التاريخي الطبقي المحدد من الدولة، ويرفض علاقات الإنتاج البرجوازية الخ . .) ، (27) .
كما أن القوى العاملة مدعوة (لممارسة العنف الثوري ، من حيث هو عنف طبقي ، بأدواتها هي وبمنطقها هي وبنظامها هي ، من أجل القضاء على سبب وجود العنف الذي هو المجتمع الطبقي) ، (28) .
إن مهدي عامل لا يقول ذلك في فرنسا والولايات المتحدة ، بل في لبنان وسوريا والعراق والجزيرة العربية ، فبدلاً من معرفة ما يحدده شاكر مصطفى وأدونيس من دولة استبدادية طائفية إقطاعية متخلفة ، يقوم مهدي بصناعة دولة موهومة هي الدولة البرجوازية ، وقد اكتملت علاقات الإنتاج الرأسمالية فيها ، وبين النموذج الواقعي الذي يرفض الدخول فيه وتحليله ، يجر نموذجاً آخر ويريد مجابهته ، وهذا الجر يخلق مهمات سياسية وعسكرية مختلفة ، فهو هنا يريد إزالة البرجوازية بالقوة ، فتتحول هذه الكلمات في يد اليساري اللبناني إلى سلاح ، ويغدو كل الفلاحين المقتلعين من الجنوب والنازحين على المدن والفقراء ، جيش الثورة البروليتارية في مواجهة البرجوازية .
إن مهدي عامل بعد أن حول المجتمع المتخلف الطائفي التابع الجائع إلى المصانع والبرجوازية إلى (مجتمع برجوازي مأزوم بسيطرة هذه البرجوازية) ، لم تعد المهمة سوى اقتلاع هذه البرجوازية لكي تحل الأزمة ، وهكذا يُفتح الطريق للحرب الأهلية اللبنانية من البوابة النظرية .
لا يعني ذلك بأن توصيفات أدونيس للمجتمع العربي التقليدي متكاملة ولا أن الحلول التي يطرحها لتجاوز أزمة المجتمعات العربية التقليدية ، فهي كذلك تعاني من عدم فهم سيرورة التطور العربي.
إن أدونيس يقول حسب رواية مهدي عامل بأن (شخصية العربي ، شأن ثقافته ، تتمحور حول الماضي / القديم) . وأنه في الحضارة العربية (لما انتفى الفرد في الموضوع وتغرب عن ذاته في الجماعة أو الدولة أو السلطة أو النظام … كان الاتباع ، وكان التخلف ، وكان حاضر الإنسان العربي أو ماضيه) ، (29) .
نستطيع أن نقول بأن مقاربة أدونيس للتشكيلة الإقطاعية تركز هنا على غياب الوعي الفردي (البرجوازي) ولكنه يجعله مطلقاً ، والمسألة ليست مسألة انتفاء الوعي الفردي فهذا مظهر للبنية الإقطاعية التي جعلت الفئات الوسطى تابعة لها ، ولكنه وهو حين يشير إلى (تلاشي) الفرد المبدع أو هيمنة التقليد في الحضارة القديمة ، فهو يشير إلى شيء موضوعي لم يتبينه تمام التبين ، وهو سيطرة الهياكل الإقطاعية العامة الاقتصادية والاجتماعية والإيديولوجية ، ولهذا فإن الفردية، وتوسع الفئات الوسطى الحرة ، وبالتالي انتشار الإبداع لم يحدث بصورة جذرية ، وقد تتبعنا ذلك في قراءات سابقة ، وبينا جذور الفئات الوسطى وارتكاز قواها الأساسية على الدولة الإقطاعية . وبهذا فإن الفئات الوسطى العربية في الماضي والحاضر ، لم تستطع أن تتحول إلى طبقات برجوازية كلية ، وهذا بخلاف رؤية مهدي عامل التي تقول بأنها وُلدت كبيرة ناجزة بفعل الأزرار السحرية الغربية ، ولكنها بعد كما يقول أدونيس كذلك لم تستطع حتى الآن أن تزيح الاتباع وتنشر الحرية بشكل شامل!
تلخيصاً وتطويراً لما سبق، يقيّم مهدي عامل تقييماً سلبياً الجوانب التي يتلمسها المفكرون المنبثقون من الفئات الوسطى الحديثة والتي تميل لتشكيل النظام الرأسمالي الحديث بكل قسماته ، فمهدي عامل يقوم بإزاحة لهذا المجتمع التقليدي الحقيقي المرفوض من قبل هؤلاء المفكرين ، ويضع بدلاً منه توصيفات مستقاة من تطور أعلى ، هو تطور البلدان الرأسمالية المتطورة ، ويضع المهمات التي تواجه الطبقات العاملة في هذه البلدان الرأسمالية المتطورة ، والتي تعالج مهمات تاريخية مختلفة ، وبدلاً من تشكيل جبهات موسعة للقوى الحديثة والديمقراطية لإزاحة التشكيلة الإقطاعية الطائفية العربية ، فإن يوجه القوى ضد أحد الأجنحة المهمة في عملية التغيير الديمقراطية ، ولهذا فهو يجعل ممثلي القوى الليبرالية والعقلانية الفكرية في الندوة المذكورة ، كخصوم ألداء وليس كحلفاء في معركة واحدة ضد تشكيلة تجاوزها التاريخ .
وهذا يقوده لعدم تثمين الأحكام الموضوعية التي يطرحها هؤلاء المفكرون والباحثون، وعدم الاستعانة بهذه المواد الفكرية الثمينة لتطويرها عبر المنهج المادي الجدلي، ورؤيتها في سياق التشكيلة الحقيقية.
ولكن مهدي عامل دخل في قراءة التاريخ بذاتية ثورية تـُسقط رغباتها على التاريخ الحقيقي ، بدلاً من اكتشاف تطوره ، فكان ابتكاره لمقولة (أسلوب الإنتاج الكولونيالي) بداية لخرقه أساسيات المادية التاريخية ، حول أساليب الإنتاج المحددة والُمكتشفة ، وهذا الخطأ المحوري قاده إلى سلسلة من الأخطاء النظرية في تحليل الجوانب المحددة في تطور التشكيلة الإنتاجية العربية ، السابقة الذكر، فهو قد اعتبر علاقات الإنتاج الرأسمالية مُـنجزة في حياة المجتمعات العربية منذ نهاية القرن التاسع عشر ، وهذا ما دعاه إلى عدم تثمين حلقات التنوير المتعددة التي قامت بها الفئات المتوسطة العربية ، في الماضي والحاضر ، ثم الدعوة إلى خلق اصطفاف حاد إلى معسكرين رأسمالي تجاوزه التاريخ ، وعمالي يجب انتصاره .
وكان هذا خرقاً للمهمات الحقيقية لقوى الثورة والتغيير العربية التي تواجه تشكيلة متخلفة ، ولكن الخطوط الفكرية التي طرحها مهدي عامل كانت تتضافر ووضع دولي مواتٍ ، مما جعلها في حيز التنفيذ ، ولكن النتائج المترتبة على هذه الخطوط النظرية والسياسية كانت كارثية خاصة على البلدان التي طبقتها بشكل عنيف ، وأهم هذه النتائج إن القوى السياسية ما قبل الرأسمالية ، والمذهبية الاجتماعية ، هي التي استفادت من تناحر القوى الحديثة ، وهي التي برزت إلى السطح والفاعلية ، حيث ساعدتها عوامل أخرى ، مما أوضح بشكل جلي بأن مهمات حركات التغيير العربية لا تزال مواجهة الأبنية التقليدية ، وضرورة عدم التحالف مع هذه القوى التقليدية وابرازها ، رغم السهولة التي تبدو بها عمليات التحالف مع هذه القوى الماضوية ، وضرورة تكريس تحالف الجبهة النهضوية التحديثية الديمقراطية ، حتى لو كانت الصعوبات جمة في طريق تشكيله وتعزيز عناصره الديمقراطية والعلمانية .
لكون التحالف مع القوى التقليدية وتعزيزها هو تقوية للتشكيلة الإقطاعية وسيرورتها الطويلة في الحياة العربية ، لأنها تشكيلة متكاملة ومتجذرة ليس في الحياة السياسية ولكن أيضاً في الحياة الاجتماعية والفكرية.
ونظن لو كان المناضل والمفكر مهدي عامل حياً ، لكان قد راجع الكثير من أفكاره ، التي كان يعززها حينذاك وضع عالمي مختلف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#المنبر_التقدمي رأس المال الحكومي الشرقي أسلوب الإنتاج الكولونيالي رأس المال الكولونيالي
المنبر التقدمي يسفه ويشوه حقداً وضغينتاً ضد عبـــــــدالله خلــــــــيفة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هوامش ومصادر:
لهذا فإن القول بوجود بنية كولونيالية أمرٌ يفتقد إلى التحليل المادي التاريخي.
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=413619
البنية والوعي
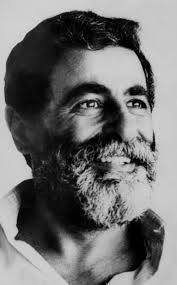
اختلف مع العديد من المفكرين حول رؤيتهم لمسار المجتمعات العربية الإسلامية الراهنة، ولاسيما مع المفكر اللبناني الراحل مهدي عامل في مفهومه عن [أسلوب الإنتاج الكولونيالي]، الذي أراد أن يجعله توصيفاً لمجتمعات العالم الثالث التي منها مجتمعاتنا.
وقد استفاد مهدي عامل من تطورات الفكر الماركسي في فرنسا، وخاصة تطورات البنيوية الوظيفية على يد غولدمان وآلتوسير، اللذين ركزا على مفهوم [ البنية]، باعتبار كل مجتمع بنية خاصة لها قوانين تشكلها، غير المنفصلة عن قوانين تطور التشكيلة الاجتماعية ـ الاقتصادية التي تضم مجموعة من المجتمعات، والبنية ذات مستويات ثلاثة: اقتصادية وأيديولوجية وسياسية، وهي مستويات متداخلة، كل منها له أهميته التكوينية في مسار البنية، وبهذا ينتهي ذلك الفصل التعسفي بين الاقتصادي والفكري والسياسي.
وقد طبق مهدي عامل هذا المفهوم على مجتمعات العالم الثالث، رافضاً إنها مجتمعات إقطاعية أو رأسمالية، أو فقط مجتمعات تابعة، مقترحاً أسلوباً جديداً للإنتاج هو الأسلوب الكولونيالي، فهي مجتمعات تابعة، غير قادرة على إنتاج بورجوازية وطنية قادرة على تشكيل مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية.
وبطبيعة الحال هذه المقولة تكمل الوعي اللينيني باستباق قيادة البرجوازية وقيام العمال بتشكيل هذه الثورة.ويواصل مهدي عامل ذلك قائلاً بأنها تابعة للرأسمالية الأقوى، وبالتالي لا يمكن أن تقوم بعملية القطع في بنية التبعية.
وفي رأيي فإن مهدي عامل لم ينطلق من درس تطور المجتمعات العربية الإسلامية، أي ما هي أساليب الإنتاج في دول المشرق الذي صار عربياً، وكيف ظهر الإسلام وفي أي بنية وما هي تطورات هذه البنية.
إذا أخذنا مثالاً بسيطاً على مفهوم البنية، فنقول عن سلطة الاحتلال الإنكليزية في الدول العربية في بدايات القرن العشرين، هل كانت سلطة رأسمالية أم إقطاعية؟
إن قانون البنية هنا يقول بأن البنية الاجتماعية لها قوانينها الداخلية، وهي التي تستقبل المؤثرات الخارجية وتعيد تشكيلها داخلياً، فنحن قد نأخذ أداة غربية متقدمة ولكن شروط وجودها في بنيتنا الوطنية تعيد تشكيلها حسب قوانينها، فالتلفزيون المنتج يغدو عندنا أداة ترفيه، وكذلك فإن قائد الاحتلال البريطاني الذي يسجن من يقوم بتعدد الزوجات في إنكلترا حين تدوس أقدامه أرضاً عربية يقبل بهذا التعدد.
وكذلك فإن كافة المنتجات الثقافية والاقتصادية تخضع لإعادة التشكيل داخل البنية، فيغدو المستعمر البريطاني رئيساً لسلطة إقطاعية.وتغدو عمليات التحديث الرأسمالي المحدودة غالباً في بنية إقطاعية مهيمنة.لكن هذا الإقطاع عرف سيرورة خاصة تمثل تطور المجتمعات العربية الإسلامية، التي تغدو فيها المذهبية شكلاً دينياً محافظاً للصراع الاجتماعي.
ولهذا فإن تكون الفئات المتوسطة في مجتمعاتنا هو تكون تابع أولاً للإقطاع، فتبعيتها للإقطاع هو الذي يجعلها تابعةً للإمبريالية. إن عدم تجذر الخطاب الفكري والسياسي للفئات المتوسطة، يعود لهذه التبعية المركبة.
لو أخذنا المجتمع اللبناني كمثال لقرأناه بوصفه مجتمعاً إقطاعياً مذهبياً نموذجياً. فكافة الشرائح التي تبدو قوى برجوازية هي قوى لإقطاعية مذهبية ودينية مختلفة. الحزب الاشتراكي التقدمي هو يافطة للإقطاع الدرزي والمهيمنين فيه، أي أن الشريحة المتوسطة في الطائفة الدرزية لم تستطع أن تغير الإقطاع المهيمن عليها، أي أن تغدو جزءً من طبقة برجوازية قائدة، وهذا يحتاج لشروط اقتصادية، عبر تعاضدها مع الشرائح الوسطى في الطوائف الأخرى، وفكرية عبر إزاحة الوعي الطائفي المهيمن في الفكر السياسي الدرزي وغير الدرزي، وبقراءة نقدية للوعي الدرزي باعتباره إحباطاً للنضال الثوري عند الفلاحين المسلمين في العصر الوسيط وهيمنة للإقطاعيين على إنتاج هذا الوعي والسيطرة على الفلاحين الذي تقسموا وفقدوا قدرتهم على الكفاح الطبقي العام، وهو أمر يُعاد إنتاجه في المجتمع الإقطاعي اللبناني الحديث، عبر مستوى آخر من تطور البنية وتداخلها مع الهيمنة الأجنبية.
ويمكننا أن نأخذ الوعي الفرنسي الملبنن كنموذج يواصل متابعة المسألة على صعيد الوعي، ونرى كيف إن وعي الثورة الفرنسية المستورد إلى لبنان تحول إلى كهنوت، أي أنه لم تستطع أفكار ديدرو وفولتير وجان جاك روسو أن تطيح بسيطرة الكنيسة والملالي على الوعي. فلماذا صار ميخيائيل نعيمة صوفياً؟ ولماذا ترنحت الثورة الرومانتيكية عند جبران خليل جبران؟ ولماذا صار الحزب الشيوعي اللبناني تابعاً لحركة القوى المذهبية عوضاً أن يقود معركة لتشكيل مجتمع حديث لا طائفي؟ أي كيف غدت الماركسية ديناً وعقيدة ؟ أي لماذا لم تستطع الفئات الوسطى والشعبية فيه أن تغدو علمانية؟ أي لماذا ابتعدت أدوات مهدي عامل من الحفر والهدم للمجتمع الإقطاعي اللبناني الطائفي كتشكيلة حقيقية وليس كمجتمع كولونيالي؟
تكمن الإجابات في الحفر المزدوج الماضوي والحديث، عبر دراسات ملموسة في تكوينات المجتمعات وتطوراتها الخاصة، أي تحولها من كيانات داخل الإمبراطورية الإسلامية إلى كيانات وطنية، وكيف تمت التطورات والصراعات القديمة والحديثة، وكيف ومتى حدثت التغيرات في البُنى الإقطاعية في كل بلد بلد، وفي المستويات الثلاثة السابقة الذكر، وهل وصلت هذه التغيرات إلى الخروج من التشكيلة؟
إننا في لحظة تاري
November 27, 2021
عبـــــــدالله خلــــــــيفة : فالح عبدالجبار
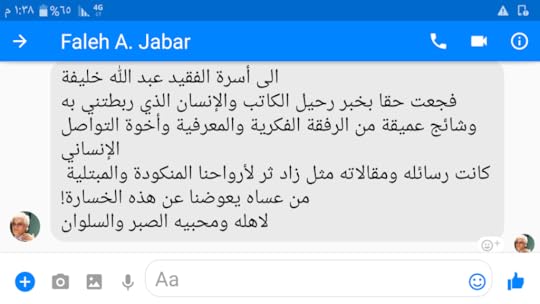 رسالة المفكر العراقي الراحل فالح عبدالجبار لأسرة الكاتب والروائي عبـــــــدالله خلــــــــيفة للتعزية بالفقيد .
رسالة المفكر العراقي الراحل فالح عبدالجبار لأسرة الكاتب والروائي عبـــــــدالله خلــــــــيفة للتعزية بالفقيد .



