عبـــــــدالله خلــــــــيفة's Blog: https://isaalbuflasablog.wordpress.com , page 72
November 5, 2021
عبÙÙÙÙÙÙÙداÙÙÙ Ø®ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙØ© : Ù Ùراث Ø´Ù ÙÙÙ
Ùا٠ÙÙÙترض أ٠تÙÙÙÙ Ø«ÙاÙة٠اÙÙسار٠ÙاÙÙÙ٠اÙتØدÙØ«ÙØ© Ø«ÙاÙØ©Ù Ù
ÙضÙعÙØ© تدÙ
ج اÙعÙÙاÙÙØ© بÙ
ÙضÙعاتÙا ÙتØÙÙÙاتÙØ§Ø ÙÙÙ Ùذا Ùا ÙØدث بشÙ٠عاÙ
ÙÙ
ستÙÙÙ
Ø Ùأ٠اÙبرجÙازÙØ© اÙصغÙرة اÙÙ
دÙÙØ© ÙÙ٠تشÙÙ٠تÙظÙÙ
ات Ø´Ù
ÙÙÙØ©Ù Ù
تØزبة ÙذاتÙا بشÙÙ Ù
ØªØ¹ØµØ¨Ø Ø³Ù٠تؤÙÙ٠تارÙØ®ÙÙا ÙÙ
بادئÙا ÙÙÙاداتÙا ÙتدخÙÙا ÙÙ Ùطا٠اÙÙ
ÙØ¯Ø³Ø ÙÙ
Ù ÙÙا ÙتÙار٠اÙÙÙد٠ÙاÙتØÙÙ٠اÙÙ
ÙضÙعÙ.
ØÙ٠تتØÙ٠اÙبرجÙازÙة٠اÙصغÙرة٠اÙسÙاسÙØ© Ù٠اÙÙ
د٠ÙتضعÙÙ Ù
ÙاÙÙ
تÙا بسبب Ùذا اÙتعصب ÙاÙاÙغÙاÙØ Ø³Ù٠تÙرث٠خصائص٠سÙبÙØ©Ù ÙÙÙÙ٠اÙبرجÙازÙØ© اÙصغÙرة اÙطاÙعة Ù٠اÙرÙÙ ÙاÙبادÙØ©.
Ù
٠اÙصعب ÙجÙد Ùع٠ÙÙد٠Ù
ÙضÙع٠عÙد Ùع٠ÙØÙ٠اÙتÙظÙÙ
ات ÙاÙØ£ÙÙار ÙاÙشخÙص ÙاÙدÙ٠إÙÙ ÙائÙات٠Ù
ÙØ¯Ø³Ø©Ø ÙØ°ÙÙ Ùإ٠تÙرب اÙعاÙÙ
اÙثاÙØ« اÙاجتÙ
اعÙØ© غÙر Ù
Ùتجة ÙÙدÙÙ
ÙراطÙØ© ÙأغÙبÙا تعÙد Ø¥Ùتاج اÙاستبداد اÙدÙÙÙ ÙاÙاستبداد اÙسÙاسÙ.
إ٠اÙÙع٠(اÙØ´ÙÙعÙ) Ùر٠اÙاتØاد اÙسÙÙÙت٠ÙرÙ
Ùز٠ÙائÙات Ù
ÙØ¯Ø³Ø©Ø Ù٠اØتÙاÙاتÙا ÙسÙاساتÙا ÙتارÙØ®ÙØ§Ø ÙسÙÙ Ùر٠اÙÙÙÙ
Ù ÙسÙÙ Ùر٠اÙبعث٠ذات٠اÙخصائص Ù٠اÙدÙÙ ÙاÙزعÙ
اء اÙØ°ÙÙ ÙØرÙ٠اÙبخÙر اÙسÙاس٠ÙÙÙ
.
سÙÙ ÙخرجÙÙÙ
Ù
٠دائرة٠اÙÙاÙعÙØ ÙÙ
٠إÙ
ÙاÙÙØ©Ù ÙجÙد أخطاء عÙ
ÙÙØ© ضاربة ÙÙ Ùذا اÙبÙاء ÙÙ
ا جر٠ÙعÙاÙ. ÙÙÙذا سÙ٠تÙÙ٠سÙاستÙ٠اÙÙÙÙ
ÙØ© ÙائÙ
ة٠عÙ٠اÙتصار Ùذا اÙÙÙ
Ùذج غÙر اÙÙاب٠ÙÙÙزÙÙ
Ø©Ø ÙسÙ٠تشتغ٠اÙتÙتÙÙات٠تبعا٠ÙÙذ٠اÙÙدرÙØ© اÙدÙÙÙØ©Ø ÙسÙ٠تدخÙ٠أÙصاÙ٠اÙØÙائ٠ÙاÙتارÙخ٠اÙÙ
ؤدÙج اÙرسÙ
Ù Ùتجزئة٠اÙتØÙÙÙ ÙاÙتصار٠عÙÙ Ù
ا ÙÙÙع٠اÙذات ÙÙا ÙضرÙØ§Ø ÙتÙØ®Ù٠جÙاÙب ع٠اÙÙÙاعد ÙتظÙر جÙاÙØ¨Ø ÙتصبØ٠اÙÙÙعÙة٠اÙاÙتÙازÙØ©Ù Ù
تغÙغÙØ©Ù ÙÙصبØ٠اÙرÙاÙÙ Ø´ÙØ© Ù
ستÙÙدة بدÙا٠Ù
٠تÙظÙÙ
Ø«ÙرÙ. ÙÙأت٠اÙÙ
Ø°Ùب٠اÙÙ
رتÙز٠عÙ٠اÙدÙ٠اÙإسÙاÙ
٠بعد أ٠صدأت Ø¢Ùات٠اÙØ£Øزاب (اÙØ«ÙرÙØ©) اÙÙدÙÙ
Ø©Ø Ù
٠دÙ٠أ٠ÙÙعرÙÙ ÙÙ
اذا صدأت٠إÙا ÙÙÙÙÙÙا Ù
خاÙÙØ© ÙÙتعاÙÙÙ
اÙرباÙÙØ© بØسب ÙÙÙ
ÙØ ÙÙÙس ÙØ£ÙÙا تستÙد٠عÙÙ ÙÙ٠اجتÙ
اعÙØ© Ù
تذبذبة ÙÙعÙØ© Ùخاصة Ù
Ù Ùب٠اÙÙادة اÙØ°ÙÙ ÙرسÙÙا ÙÙÙ
Ø ÙÙÙ
تÙÙ
عÙ٠اÙتÙظÙÙ
ات اÙجÙ
اعÙØ© ÙدÙÙ
ÙراطÙتÙا ÙÙ
ؤتÙ
راتÙا ÙÙتبÙا اÙÙÙدÙØ© اÙÙاØØµØ©Ø ÙÙ٠سÙÙÙÙ
٠بذات اÙÙعÙØ ÙÙطبÙÙ ÙÙس٠اÙÙ
بادئ اÙداخÙÙØ© اÙاجتÙ
اعÙØ© اÙÙ
رÙضة ÙÙÙس أشÙاÙÙا اÙخارجÙØ© اÙسطØÙØ©.
ÙÙذا اÙتارÙØ® اÙØ°Ù ÙعتبرÙ٠اÙتصارا غÙبÙا٠ÙÙ Ùارثة عÙÙÙØ ÙØ£Ù٠سÙÙ ÙÙسخ٠أسÙØ£Ù Ù
ا ÙÙÙØ Ø¨Ø¯Ùا٠Ù
٠أ٠ÙÙÙÙ ÙÙ ÙتÙظÙÙ
Ù Ø«Ù
رة٠ÙتارÙخ٠سÙاس٠غÙ٠دÙÙ
ÙراطÙ.
Ø¥Ù٠سÙÙÙض٠ÙÙ٠عضÙات اÙÙادØÙÙ ÙÙØ·ÙعÙا Ù
٠أج٠صعÙدÙØ ÙستÙÙÙ Ù
عرÙت٠Ù
٠أج٠اÙتصار (دÙÙØ© اÙØÙ)Ø ÙÙتØاÙÙÙ Ù
ع اÙÙ
خاÙÙÙÙ ÙÙشرÙعة ÙÙØ· ÙØ£ÙÙ ÙÙظÙÙÙ
Ùأج٠Ù
صÙØتÙØ ÙÙا تغد٠اÙاÙتÙازÙØ© ÙاÙØ¹Ø©Ø Ùخاصة Ù٠اÙدÙ٠اÙت٠ÙÙس ÙÙا تراث Øزب٠سÙاس٠عرÙÙØ ÙÙÙÙ٠اÙÙد٠عÙ٠شأ٠جÙ
اعت٠Ù
٠أج٠اÙÙراس٠ÙاÙØصص اÙÙ
اÙÙØ© ÙاÙÙ
ÙاÙع.
اÙتراث اÙسÙب٠ÙÙجÙ
اعات (اÙعÙÙ
اÙÙØ©) Ù
٠اÙتÙازÙØ© ÙØ´Ù
ÙÙÙØ© ÙتØاÙ٠عÙ٠اÙتØÙÙÙات اÙسÙاسÙØ© اÙÙ
ÙضÙعÙØ© ÙجعÙÙا ÙخدÙ
Ø© اÙذات ÙÙ
صاÙØÙØ§Ø ØªØºØ¯Ù Ù٠اÙطبÙات اÙسÙÙÙ ÙÙخطاب اÙسÙاس٠اÙطائÙÙ (اÙÙبÙÙ)Ø ØºØ§Ø¦Ø±Ø©Ù ÙجزءÙا Ù
Ù Ù
رض اÙطبÙØ© اÙÙ
تذبذبة اÙاÙتÙازÙØ©Ø ÙÙ٠اÙÙ
طبخ تÙعدÙ٠اÙØ£ÙÙات اÙÙ
سÙ
ÙÙ
Ø© ÙÙØ´Ø¹Ø¨Ø ÙتÙتب٠باÙجÙ
٠اÙعظÙÙ
Ø© ÙاÙÙÙÙ
ات اÙÙØ®Ù
Ø© اÙت٠تذÙب ÙرÙ
Ùز اÙÙ
Ùدس ÙتضعÙا Ù٠أعÙ٠اÙدÙØ§Ø¦Ø±Ø ØªØ³Øر٠اÙجÙ
ÙÙر٠ÙتÙدخÙ٠اÙسÙ
ÙÙ
Ù Ù٠عظاÙ
Ù٠اÙسÙاسÙØ© ÙÙÙ ÙÙÙÙ
باÙØ£Ùعا٠اÙÙ
غاÙرة ÙأخÙاÙÙØ© اÙØ¥ÙساÙ.
اÙÙ
ÙضÙعÙØ© ÙاÙØÙÙÙØ© تتطÙبا٠اÙدÙاع ع٠Ù
صاÙØ Ø§Ùشعب Ù
Ù Ø®Ùا٠اÙأدÙات اÙÙ
تاØØ© اÙسÙÙ
ÙØ© اÙعÙÙاÙÙØ© ÙÙتÙ
تصاعدÙا عبر اÙتارÙØ® ÙØ¥Ù
ÙاÙÙات اÙشعب اÙÙ
ÙØد Ùا اÙطائÙØ©Ø ÙÙجر٠ÙÙد اÙÙاÙع ÙاÙتØاÙÙ Ù
ع اÙÙÙ٠اÙأخر٠اÙÙ
شارÙØ© Ù٠ذات اÙØ£Ùدا٠بØسب طابع ÙظرÙ٠اÙبÙد اÙÙ
عÙÙØ ÙÙراءة درجة تطÙرÙØ ÙÙÙصÙع اÙÙ
Ù
Ù٠اÙÙ
عÙÙ٠اÙÙ
ÙÙد ÙÙأغÙبÙØ© Ù
٠اÙسÙاÙØ ÙÙا Ùجر٠اÙÙجÙØ¡ Ø¥ÙÙ Ùسائ٠اÙعÙÙ ÙاÙÙذب ÙاÙتÙÙÙÙ ÙاÙخداع.
ØÙ٠ترÙد Ø£Ù ÙÙتبÙا ÙÙدا٠ضد دÙÙØ© Ù
تÙاÙÙ
Ø© اÙخطر اÙعسÙر٠عÙ٠اÙÙ
ÙØ·ÙØ© ÙسÙتÙÙØ ÙÙØ· ÙØ£ÙÙÙ
ÙشارÙÙ٠اÙطرÙ٠اÙدÙÙÙ ÙÙس اÙتÙÙÙر ÙÙذ٠اÙدÙÙØ©Ø Ù
٠دÙ٠أ٠ÙرÙا اÙأخطار اÙÙ
ØدÙØ© اÙÙائÙØ© Ù
٠طرÙÙا Ù٠اÙسÙاسة عÙ٠اÙØÙاة ÙاÙتطÙر Ù٠اÙÙ
ÙØ·ÙØ©.
ÙÙا Ù
ثا٠Ù
ÙÙ
Ùس عÙÙ ÙÙÙÙØ© اÙتØاÙÙ ÙعدÙ
اÙÙÙد اÙÙ
ÙضÙع٠ÙاÙÙصÙ٠بÙذا اÙÙÙد Ø¥Ù٠آÙا٠Ù
٠اÙتطÙر اÙدÙÙ
Ùراط٠اÙØÙÙÙÙØ ÙØ£Ù٠باÙسÙÙت ع٠دÙÙØ© خطرة عÙ٠اÙبشر تؤدÙج رأÙÙ ÙÙا تطÙرÙØ ÙÙعÙس Ø°Ù٠طر٠اÙØربائÙØ© اÙسÙاسÙØ© ÙÙتÙÙا ÙÙتØÙÙ٠اÙÙ
ÙضÙعÙ.
عدÙ
ÙÙد اÙÙÙ٠اÙعÙÙا Ù٠اÙÙ
راØ٠اÙسابÙØ© ÙاÙØ£ÙظÙ
Ø© اÙØ´Ù
ÙÙÙØ© اÙسابÙØ© Ø£ÙÙ ÙÙ
Ùت اÙتØدÙØ«ÙØ© اÙتابعة ÙÙØ§Ø ÙتدÙÙرت اÙرؤ٠اÙعÙÙاÙÙØ© اÙÙ
ÙضÙعÙØ© اÙÙÙدÙØ©Ø ÙتÙ
اشت Ù
ع صعÙد ÙÙÙ Ø´Ù
ÙÙÙØ© جدÙدة ÙÙزداد اÙÙع٠اÙسÙاس٠تدÙÙرا٠عبر Ùذا اÙتارÙØ®.
October 27, 2021
عبـــــــدالله خلــــــــيفة : دراسة تطبيقية لرواية «التماثيل» إعداد اﻟطﺎﻟﺑﺔ ــ ﺳﻌﯾدة ﻗﺎﻗﻲ
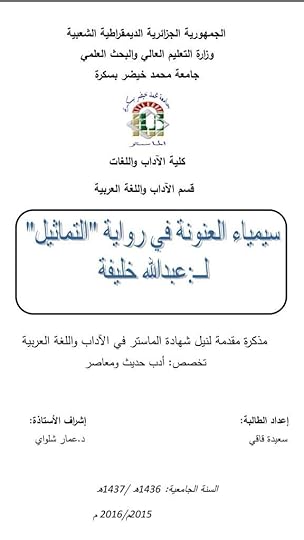
سيمياء العنونة في رواية «التماثيل» لـ عبـــــــدالله خلــــــــيفة
كتب : ﺳﻌﯾدة ﻗﺎﻗﻲ
بنى العنوان في روايــــة «التماثیل»
1 – البنیة الأيقونة.
2 – البنیة الصوتیة.
3 – البنية الصرفية.
4 – البنیة التركیبیة.
5 – وظائف العنوان في الرواية.
أولا: الأيقونة
ترتكز هذه البنية على إبراز دلائل تصميم الغلاف، وفي مفهومها العامي علامة تحيل إلى الشيء الذي تشير إليه بفضل صفات تمتلكها، خاصة بها وحدها، سواء كان هذا الشيء صفة أو كائنا فردا أو قانونا بمجرد أن تأخذ الأيقونة هذا الشيء. و تستخدم علامة له.
ويمكن اعتبار الأيقونة بمثابة عالمة محددة بموضوعها، استنادا إلى طبيعته الداخلية. وانطلاقا من هذه البنية التي تسلط الضوء على العتبات أو ما يسمى بالنصوص المصاحبة، والتي نميز بها فضاء الرواية كمفاتيح للولوج إلى رواية «التماثيل» نبدأها بصفحة الغلاف.
1 / الغلاف:
إن أول ما يجلب انتباهنا عند رؤية الرواية هو الغلاف، فهو العتبة الأولى من عتبات النص الهامة، إذ يمثل في الدراسات النصية المعاصرة حقلا سيميائيا، يعج بكل ما يحتويه من مفاتيح مكتوبة (اسم المؤلف، العنوان) ومرئية (صورة، ألوان) تسمى بالمناصات أو العناصر الموازية للنص، أي ما يحيط بالنص من سياج أولي وعتبات «بصرية و لغوية».
ومن هنا نجد غالف هذه الرواية «التماثيل» ملفت للانتباه ومثير للفضول، بحيث يجذب القارئ ويأسره فهو يتكون من وحدات نصية تجعل منه محطة للفت الأنظار، فالصورة الموجودة على صفحة الغلاف، تحمل دلالة معينة، وكذلك الألوان المختلفة التي تشكل لوحة فسيفسائية، فكل لون له دلالة معينة يحملها في ذاته وكذلك اسم المؤلف وكذا التجنيس الذي يجب أن يكون على صفحة الغلاف، أي جنس العمل الأدبي إن كان (رواية، قصة، مجموعة شعرية) بالإضافة إلى العنوان بحد ذاته كيف كتب، بخط غليظ، وبأي لون، فالعنوان هو تلخيص لموضوع الرواية ومنه فإن الغلاف في الرواية هو كطعم يستخدمه لجذب المتلقي أو القارئ، وبالتالي فإن جمالية رواية «التماثيل» تكمن في الوحدات التي تحتويها وهي الصورة، اللون، التجنيس، اسم المؤلف، العنوان، الذي يعد وحدة كبرى تستقل بذاتها، وسنقوم بدراسة كل وحدة على حدة :
أ / الصورة:
يعتبر ماتز Mathz cheitian الرسالة البصرية مثل الكلمات وكل الأشياء الأخرى، لا يمكن أن تنفلت من تورطها في لعبة المعنى. أي أن الألوان والصورة دلالة كبيرة لفهم المعنى العام للنص ويعرف أفلاطون الصورة بأنها «تلك الظلال، أضف إليها البريق الذي نراه في الماء أو على سطوح الأجسام التي تلمع وتضيء كل نموذج من هذا الجنس».
وتعتبر عالقة الصورة بالنص السردي عالقة وطيدة، فهي تمثل الوسيط بين النص والمتلقي، إذ يعمد المؤلف من خلالها إلى تمثيل موضوع الرواية، ليحملها رموزا ودلالات متنوعة، والصورة هنا في رواية «التماثيل» هي لوحة من لوحات الفنان، وبربط الصورة بالعنوان، وبتأويل بسيط، وهي تتموقع في وسط الرواية.
فالصورة في هذا الغلاف تمثل الصورة دلفينين مفتوحي الفم الأول كبير والثاني صغير وبجانب الدلفين الأول جريدة، وهما في هذا المشهد يمثلان الصديقان حسان يوسف وياسين الفينيقي فياسين الفينيقي قام بخيانة صديقه حسان يوسف مستخدما في ذلك الصحافة حيث قام بنشر مقال قائلا فيه بأن صديقه حسان يوسف قام بسرقة الآثار، (فحسان يوسف هو رجل فقير في حين نجد صديقه هو رجل ذا سلطة ونفوذ)، وفي الجهة اليسرى من الصورة تمثال ذهبي لياسين الفينيقي وهو رمز السلطة والتجبر والخيانة والشخصية الانتهازية المخادعة والماكرة فهو يصبو إلى الثروة، فهو لا حدود له ولا يراعي لا العرق ولا القيم ولا يعترف بالمحرمات أو الموانع الأخلاقية، إلى جانب ذلك تمثال لصديقه حسان يوسف وهو أصغر منه حجما و أقل قيمة، (هو فقير لا حول ولا قوة له وهو لا يملك أي سلطة وليس له نفوذ)، وفي أسفل الصورة كتابة صغيرة تشير إلى أن الزمن الفردوسي وهو زمن علي البحراني قد مضى وانتهى، وأنه لم يبق منه شيء في حين نجد على الجهة اليمنى من الصورة مسجدا كبيرا وضخما يشير إلى الحضارة الفينيقية واهتمامها ببناء المساجد والمحافظة على التراث وكل ما يمس القيم الإنسانية والتاريخية.
ب/ اللون:
لقد اتخذ اللون وظيفة تكنولوجية عندما حل محل اللغة، ومحل الكتابة، ولهذا وجب ربط اللون بنفسية المتحدث، وبنفسية المتلقي ثم بالوسط الاجتماعي، والبيئة المحيطة بالفنان، وتسهم دلالات اللون في نقل الدلالات الخفية والأبعاد المستترة في النفس باعتبار الصورة واللون لغة عالمية تفهمها كل الشعوب والألوان هي تفسير لحالة فيزيولوجية وسيكولوجية مرتبطة ارتباطا وثيقا بحالات النفس المتقلبة وأطوارها العميقة من حب وكراهية وارتياح وطمأنينة وغيرها.
ويعد اللون جزء من حياتنا فهو يلزمنا ولا نستطيع أن نغفل عن النظر بجماله والتمعن فيه، فهو أهم عناصر الجمال التي تهتم بها، فبعض الألوان تروق لبعضنا وأخرى يتجنبها بعضنا، وهذا ما يؤكد بأن الألوان ارتبطت بشكل أو بآخر بنفسية الإنسان، فنجد بعض الأشخاص يستغرقون وقتا طويلا لاختيار اللون المناسب لطلاء منازلهم أو غير ذلك فقد حل اللون محل اللغة لذا وجب ربطه بنفسية المتحدث ونفسية المتلقي، ولكل لون دلالة معينة ارتبطت به.
وأهم الألوان بروزا على صفحة غلاف رواية التماثيل هي الأبيض، الأسود، البرتقالي، الأخضر، الأزرق.
وسنقوم بدراسة كل لون ومعرفة دلالته.
أ / الأبيض:
هو رمز النقاء والطهارة والنظافة ورمز النور وهو لون الأمل والتفاؤل والحياة ومن هنا نلاحظ دلالة هذا اللون على الخير والتفاؤل، وقد يكون السبب وراء ذلك عالقة الأبيض بالنور والإشراق.
ومن هنا جاء توظيف الكاتب للون الأبيض في رواية التماثيل، مجسدا إياه في شخصية حسان يوسف، فرغم كل ما يعانيه من فقر وعذاب وظلم من طرف صديقه ياسين الفينيقي ودخوله السجن بسبب خيانته له، إلا أنه لم يفقد الأمل وظل متمسكا بهذه الحياة وآمال ومتفائلا بغد أفضل يكون أكثر إشراقا، فرغم الظروف الاجتماعية القاسية إلا أنه لم يفقد الأمل، وبقي متمسكا بقيمه الفاضلة.
كما أن اللون الأبيض هو لون أصحاب الفكر الواضح النقي.
ب/ الأسود:
يرتبط الأسود بمعاني عديدة يمكن تلخيصها بالموت والدمار من جهة والمهانة من جهة أخرى وهذه المعاني ما زالت شائعة إلى يومنا هذا.
فالأسود لون يشير إلى الحزن والتشاؤم والخوف من المجهول لارتباطه بأشياء منفردة في الطبيعة دون سائر الألوان، فهو مرتبط بالليل والظلام، وجلبه لمشاعر الخوف هو السبب المباشر للنفور منه، فالظلام يحد الرؤية ويحجب الحقيقة وبكون مجالا خصبا للأوهام ويرتبط أيضا بالغدر والخيانة.
وقد وظف الكاتب اللون الأسود ليدل من خلاله على الحزن الذي يعيشه اتجاه حياته الاجتماعية المؤلمة وظروفه القاسية، وكذلك ليعبر من خلاله على أسفه وحزنه اتجاه الانحلال الأخلاقي وغياب القيم والأخلاق الفاضلة واضمحلال الزمن الفردوسي زمن علي البحراني كما استعمل الكاتب اللون الأسود ليعبر على الخيانة التي قاساها من طرف صديقه ياسين الفينيقي بسبب الوصول إلى السلطة، كما وظفه الكاتب لبدل من خلاله على الشعور بعدم الرضا بالظروف القائمة وعدم قبول الأمر على ما هو عليه، كما يدل على مقاومة القدر الذي لا مفر منه، فالزمن الحاضر هو زمن مؤرق زمن الرهانات على الثروة والمتعة والسلطة، زمن تمثله الشخصية الانتهازية والخائنة ياسين الفينيقي فحسان يوسف يمثل نزوحا إلى الماضي في حين ياسين يقتحم الحاضر ويصبو إلى الثروة والوجاهة. فهو حزين ومفجوع بالواقع المتوتر وبالعالم الذي تتراخى وتنعدم فيه التقاليد والأعراق والسنن، وتنبثق عن هذا الانهيار ظواهر وسلوكيات اجتماعية وسياسية متردية تنعكس على عقله ووجدانه فلا يرى مناصا من رثاء زمنه الضائع والتشبث بأطيافه المتراجعة، كما استخدمه الكاتب لأنه مرتبط بالليل والظالم، الذي يأتي بالشر ويخفي الحقائق.
ج/ البرتقالي:
يرمز إلى الدفء والانجذاب والشوق، فقد وظف الكاتب اللون البرتقالي لتدل من خلاله على الانجذاب الدفيء والحنين إلى الزمن الماضي، الماضي العريق، ماضي الحضارات والقيم الفاضلة والآفلة، ماضي علي البحراني الذي جاء من الصحراء، وأسس مملكة العيون، فحفر الينابيع وزرع البساتين وكشف بحيرات اللآلئ في البحر فهو زمن استخراج الثروات وحمايتها من الإرهابيين الذين يحاولون سرقة الآثار والثروات فهو مشتاق إلى ذلك الزمن في ظل الأوضاع الاجتماعية والسياسية التي يعيشها، واهتمام الناس بالسلطة والنقود ودحر وترك كل ما هو عادات وتقاليد وتراث.
د/ الأخضر:
ويرمز إلى الهدوء والحياة والاستقرار والازدهار والتطور والنماء وله دلالة على الحياة والأمل والاستبشار وبخاصة إذا جاء بعد اللون الأحمر فيكون هو الغالب والمسيطر والمطلوب.
وقد وظف الكاتب اللون الأخضر ليدل من خلاله على حب الحياة والتشبث بها مهما كانت الظروف صعبة، فرغم كل ما يعانيه حسان يوسف من ظلم وقهر وخيانة من طرف صديقه ياسين الفينيقي، إلا أنه لم ييأس ولم يفقد الأمل في الحياة وكان دائما يسعى جاهدا لإثبات براءته، وأنه مخلص للوطن، كما يدل اللون الأخضر في الرواية على حب القيادة والسيطرة وهذا ما تجسده شخصية ياسين الفينيقي من خلال استعماله جميع الوسائل الأخلاقية وغير الأخلاقية من أجل الوصول إلى السلطة وتحقيق كل أهدافه.
هـ/ الأزرق:
ينقلنا اللون الأزرق القاتم إلى عالم الخمول والكسل والهدوء والراحة واللون الأزرق الخفيف يوحي بالقلق النفسي والاضطراب والحيرة التي تتناسب مع نفسية الكاتب.
وعند العرب لم يتحدد مدلول الأزرق بل تداخل مع ألوان أخرى كالأبيض والأخضر ومن مدلولات الأزرق كذلك الصفاء والشفافية وغالبا ما تعاملت هذه الشفافية مع مفردات الواقع السياسي وغالبا ما يتصل بعالم السماء وعالم الأرض، من ماء ومحيطات وبحار وغيرها وهو أيضا يحمل دلالة الحزن والكآبة والضياع التي تتلائم ونفسية، وقد وظف الكاتب اللون الأزرق ليدل من خلاله على الحيرة والاضطراب والقلق النفسي الذي يعاني منه حسان يوسف فهو قلق تجاه الأوضاع السياسية والاجتماعية، وغياب الضمير الأخلاقي وتعفن المجتمع في الماديات وتجاهله للمعنويات، أي أن المادة هي المسيطرة، كما أنه يشعر بالحيرة اتجاه المجتمع واهتمامه ببناء العمارات الفخمة والمحلات الضخمة وتجاهله لعاداته وقيمه الإنسانية، كما يترجم اللون الأزرق في الرواية شخصية حسان يوسف على أنها شخصية هادئة متحفظة ذات قيم وطموح تنسجم مع كل مكان وتترجم الحياة ترجمة مثالية راقية.
ج/ التجنيس:
«التجنيس أن تلقي أي جنس أدبي روائي كان أو غير روائي يتألف من اتفاق معقود بين المؤلف والقارئ الذي يرتبط بنوعية هذا الجنس على وجه التحديد، فالمؤشر الجنسي على ذلك نظام ملحق بالعنوان».
والتجنس يأتي ليخبر عن الجنس الذي ينتمي إليه هذا العمل الأدبي أو ذاك، فهو يعبر عن مقصدية كل من الكاتب والناشر، فالوظيفة الأساسية له وظيفة إخبار القارئ وإعلامه بجنس العمل/ الكتاب الذي سيقرؤه.
وقد جاء التجنيس في رواية «التماثيل» وسط الغلاف للفت الانتباه إلى أن العمل يعبر عن الذاتية ولتدل على جنسها «رواية» حيث كتبت بخط رقيق باللون الأسود الذي يعبر عن الكآبة والحزن تجاه الواقع المرير والحرمان من حياة الثراء والترف، والخوف من الوحدة والتوتر الذي يقاسيه في الزنازين والعذاب الذي يتعرض له يوميا واضطراب حالته النفسية.
د/ اسم المؤلف:
يعد اسم الكاتب من بين العناصر المناصية المهمة، فلا يمكننا تجاهله أو مجاوزته، لأنه العلامة الفارقة بين كاتب وآخر، فيه تثبت هوية الكتاب لصاحبه ويحقق ملكيته الأدبية والفكرية على عمله وغالبا ما يتموضع اسم الكاتب في صفحة الغلاف، وصفحة العنوان.
وقد جاء اسم المؤلف في الرواية في الأسفل تحت التجنيس، وقد كتب اسم المؤلف باللون الأسود وبخط غليظ ليدل على القوة والجرأة، وسيطرة اللون الأسود يدل على عمق الألم والحزن تجاه الحياة الاجتماعية والسياسية التي يشهدها المجتمع وتفشي الأخلاق الرذيلة وكذلك يدل اللون الأسود على الظلم الذي يعانيه في حياته.
ثانيا – العنوان
يعد العنوان من أهم عناصر المناص (النص الموازي).
والعنوان «التماثيل» جاء أعلى الصورة والتجنيس، فقد شغل مكانا على واجهة الغلاف، وطغى عليه اللون الأحمر، وقد تكرر العنوان في الصفحة التي تلت الغلاف، ولكن كتب باللون الأسود ليدل على الحزن والألم الذي يعيشه الكاتب اتجاه الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، وقد كتب العنوان بخط غليظ ليلفت انتباه القارئ ويجذبه، وكتب العنوان باللون الأحمر الذي يدل على الاندفاع والثورة تجاه الأوضاع التي يعيشها واندثار القيم الأخلاقية واهتمام المجتمع بالسلطة والمال والنقود دون مراعاة القيم الأخلاقية، فجاء العنوان جملة اسمية ليدل على الصمود والثبات تجاه معاناته، فالعنوان شكل مدخلا ضروريا للنص واختصارا لما جاء في الرواية، فحسان يوسف هو الشخصية المركزية وهو محور الأحداث والحركة منها تبتدأ الرواية إليها تنتهي، فعلاقة حسان يوسف بياسين في البداية كانت علاقة صداقة حميمية، إلا أن الأمر لم يبقى على حالة فتحولت تلك الصداقة إلى عداوة بسبب خيانة ياسين ورغبته في الحصول على السلطة والمال والنفوذ،
فحسان كان يعمل موظف في أرشيف الحكومة فوقع بين يديه ملف كبير وهو من عصور سالفة، تتحدث عن حكاية «علي البحراني» وكيف جاء إلى الصحراء وأسس مملكة العيون وكيف تآمر عليه أتباعه الذين أعطاهم البساتين فقتلوه فهو مؤسس هذه الأرض الخضراء المعطاء فدال على إلى العزة والكرامة والشموخ في التاريخ الإسلامي، يرمز إلى الحضارة والأصالة وكل القيم الإنسانية، واستدعاء شخصية تاريخية إلى الواقع المعاصر ذات ثقل تاريخي إسلامي هو أشبه ما يكون بالكرامة أو المعجزة، والغاية من ذلك هو اتخاذ التاريخ ستار تنعكس فيه أحداث الأمة وواقعها المرير ومخاطبة الحاضر المتردي من خلال الماضي المشرق، وبعث علي واستحضاره لم يقف عند التعامل معه على أنه شخصية تاريخية، فعلي البحراني هو الشخص الأثيري الخرافي هو الذي يحتل فضاء الرواية ويستولي على عقل حسان وذاكرته، الجد الأسطوري الأولي المحضر على شاكلة أرباب الحضارات القديمة، أما الزمن الحاضر فهو زمن الانحلال الأخلاقي والسعي إلى السلطة فتمثله الشخصية الانتهازية والخداعة ياسين الفينيقي، فنرى في الرواية نجاحات ياسين على حساب إخفاقات حسان فياسين يستخدم كل الوسائل الأخلاقية وغير الأخلاقية للأغتناء وتأكيد وجودها من خلال ظلم المحيطين به، فالرواية تحيلنا إلى النظر إلى الواقع وأنه لا شيء ثابت على حاله مطلقا.
فالهدف منها هو إثارة قضايا اجتماعية وفكرية ينطلق منها لكشف مرتكزات وأشكال الاستغلال الاقتصادي والزيف السياسي ومراد التلوث الأخلاقي والسلطوي والإضاءة على عالم المفارقات والتحولات كما مثل المكان في الرواية حضورا روائيا بارزا فالمكتب في المحكمة التي يعمل فيها يمثل (تابوت حجري) حيث يقول:
«وعجبت كيف سأقضي أيامي في هذا التابوت الحجري الورقي، أطالع الملفات العتيقة، وهي متخثرة في زمنها تتعفن يوما بعد يوم، وليس لي سوى أن أنتظر ورقة تأتي في كل شهر لتوضع في إحدى هذه الملفات وتتكفن مع رفيقاتها، وتفقد همسها ورائحتها وروحها».
والمكان الثاني هو المصرف وهو يمثل بالنسبة إليه (زنزانة أو قفص وكل ما يراه جدران تتكاثر حوله) حيث يقول:
«قالت لي نرجس بأنني سوف أعمل محاسبا لكنني وجدت نفسي عداد نقود قابعا في إحدى زنازين واجهة المصرف محاطا بحشد من المنتظرين الذي يصطف كطابور طويل يبدأ من الحديد».
وجميعها لها دلالات بينة على شعور متفاقم بالاستلاب والقهر والعجز وكان عندما يخرج من السجن بين فترة وأخرى وتصدمه هذه التحولات في البناء والنفوس والعقول إذ يقول: «هياكل البيوت القديمة تتحول في غمضة عين إلى متاجر أنيقة أسير غريبا أحاول أن أجد وجها قديما فلا يظهر».
فعنوان الرواية «التماثيل» هي أول كلمة تطالعنا، إذ تعد الكلمة المركزية والمفتاح للولوج إلى النص فكان لها حضورا مكثفا في الرواية كما نجد ذلك في الصفحة 85, 59, 78.
والمقصود بالتماثيل: هو اسم الشيء المصنوع مشبها بخلق الله، ويكون هذا التمثال في صورة إنسان أو حيوان، كما يطلق التمثال على الصورة الموجودة في الثوب، سواء كانت هذه الصورة لأشخاص أو حيوانات ويقال في ثوبه تماثيل أو صور فالتمثال هو كل ما صور على مثل صورة من حيوان أو غير حيوان، فقد أصبحت صناعة التماثيل ووضعها على الثياب ظاهرة معروفة ومنتشرة في عصرنا الحالي وفي جميع بلدان العالم إذ نرى الكثير من الأشخاص يرتدون ملابس فيها صور لشخصيات معروفة أو صور لحيوانات.
والعنوان يختصر الهدف الأساسي الذي تتضمنه الرواية ألا وهو الكشف عن الخزي والذل والعار الذي يعيشه المجتمع الإسلامي وتفشي السلوكات السلبية في المجتمع وسيطرة رجال النفوذ والسلطة على الضعفاء وظلمهم بغية تحقيق مصالحهم وأهدافهم فالكاتب أراد من خلال العنوان أن يصور لنا الصراع بين الخير والشر والفرق الشاسع بين الزمن الماضي والزمن الحاضر زمن الانحلال الأخلاقي والجري وراء السلطة باستخدام جميع الوسائل ومنه فالعنوان كان بدلالاته الموحية متشظيا في ثنايا الرواية.
1- البنية الصوتية:
إذا كانت اللّغة كلها أصوات، والصوت هو وحدة صوتية مغري يمكن تجزيئ سلسلة ّالتعبير إليها مثل: الضاد والراء والباء في ضَرَبَ التي تمثل الأصوات الرئيسية. ومنه سنحاول إسقاط الدراسة الصوتية على العنوان، وسنبدأ انطلاقا من تقسيم الأصوات حسب صفاتها مع التركيز على الأصوات الأكثر وضوحا في تأدية المعنى.
أ- الأصوات الاحتكاكية:
تخرج هذه الأصوات عند خروج الصوت مستمرا في صورة تشرب للهواء محتكا بالمخرج. وهي على نوعين: مهموسة وهي (س، ش، ق، ت، ح، خ، هـ)، والمجهورة وهي (ذ، ط، أ، ع، غ، ل، ن، م، و، ي). ومن الأصوات الاحتكاكية التي وردت في العنوان نجد صوت (التاء، والالم، والميم، والباء، والثاء) بالإضافة إلى صوت (السين) الذي ورد بكثرة في متن الرواية.
وأول ما يلفت انتباهنا في هذه الرواية، هو طغيان صوت (التاء، والسين) فهما من الأصوات الاحتكاكية المهموسة، فصوت التاء الذي يتجلى في العنوان في حد ذاته «التماثيل» كما نجده في متن الرواية إذ يقول: «حتى امتدت يدي ذات يوم إلى ملف كبير ورحت أقرأ فيه، كُنْتُ ألتفت بين لحظة وأخرى إلى الباب لكن الباب يظل ساعات متشبثا بالجدار، فكأنني كنت أمسح الغبار، أروح أقرأ».
– ويقول أيضا: «قلت لك أن تكون من جماعتي، فرفضت وَوَشَيْتَ، وأنا تعلمتُ، وغَدَوْت في كل جهة، أيُّ ريح أرها أطير معها استثمرها، أما أنت فجامد كالصخرة حتى اقتلعوك من مكانِكَ، وصرت حفرة».
– ويقول: «مصائد تختفي، بيوت تتكدس في جهة، بساتين تتوارى من التصحر والتهم أسماء انمحت وتحجرت، وكان الشيخ علي البحراني وجماعته وأتباعه يملكون كل هذه الأرض ثم اختفوا جميعا».
فصوت التاء من الأصوات المهموسة وقد وظفها الكاتب ليبينَ من خلاله الصمود والتحدي اللذان امتاز بهما حسان يوسف، فرغم الظروف القاسية التي يعانيها من فقر وظلم إلاّ أنه لم يستسلم وبقي صامدا أمام كل هذه الظروف، محاولا تجاوزها، لذا يلجأ إلى الاعتراف بكل هذه المكبوتات لأنها الوسيلة الوحيدة، التي تجعله صامدا، كما وظف الكاتب صوت (التاء) ليدل على كثرة الهموم والمشاكل وكل الظروف المعرقلة وصموده على ما اعتاده من أوجاع، أما صوت (السين) الذي يدل على الهمس فالسر عادة ما يكون مكتوما ولا يباح به إلاّ همسا، وبخاصة إذا تعلق الأمر بخواص النفس التي إذا أفَضَى بها الإنسان تبعته على إثرها صعوبات فأسرار الكاتب التي يتحدث عنها كانت في معظمها مما لا يجوز البوح به ولا الحديث عنه.
وهي الدلالة التي أداها صوت (السين) في الرواية، والكاتب يعدل إلى الهمس دون البوح فالأسرار محلها القلب والكاتب من خلال توظيفه لصوت (السين) أراد إثبات مدى الوجع والألم النفسي الذي يعانيه، وشوقه وحنينه إلى الزمن الماضي، الزمن الفردوسي زمن علي البحراني الذي فيه جميع القيم الإنسانية والحضارية إذ يقول: «هذا يريد دفاتر، وتلك تريد فستانا، هذا لا يستطيع أن ينام، وتلك سقطت في دراستها، وفي الليل يأتي أسعد ليفرض سطوته».
– ويقول أيضا: «أتساءل في نفسي: كيف استطاع ذلك؟ من أين جاء بالنقود وهو خارج من السجن، ولم ينقضي على الإفراج سوى سنة؟ هل تساقطت عليه الاوارق مثل أوراق المسرحيات والقصائد؟».
فصوت السين في الرواية يدل على رغبة الكاتب في التنفيس عن نفسه وخلق واقع جديد غير الواقع الذي يعيشه فهو مختلف بكل الأحاسيس وذلك حتى يثبت ذاته، كما وظف الكاتب صوت السين ليدل من خلاله على ضعف حسان أمام صديق ياسين فقد قام بخيانته وذلك بسبب السلطة والنفوذ.
وبذلك نستطيع أن نقول أن دلالة صوت السين في الرواية مرتبطة بخاصية تتعلق بخواص النفس من مشاعر وأحاسيس وألم ووجع.
وكذلك نجد في العنوان توظيف الكاتب للأصوات، المجهورة وهي اللام والميم. فأما اللام فقد وصفه سيبويه «بأنها صوت منحرف ينطق على نحو بين الشديد والرخو، ويبدوا أن المقصود بكونه منحرفا أنه ينطق نطقا جانبيا بمعنى أن عقبة ما توجد في وسط مجرى الهواء فيخرج الصوت من أحد الجانبين ولذا يوصف جانبي» وهو مجهور ذلقي».
ويحضر صوت اللام في العنوان الرئيسي وفي متن الرواية إذ يقول: «لماذا لا تبحث لك عن عمل بدلا من العودة للوراء؟ ما أريك أن تشتغل هنا بأسلوبك حسب الرسالة التي نشرت كان مقبولا».
ويقول أيضا: «وحدثت ضجة في الاحتفال، ومضت كتلة نارية في الفضاء، وسقطت على المسرح وتعالت الصيحات وجاء ذعر النساء مميزا، وفزع رجال الحفرة، وحمل رجلان منهما الصندوق فيما اقتادني الثالث، ودخلنا السيارة وانطلقنا».
فالكاتب أراد من خلال توظيفه لصوت اللام في العنوان الرئيسي وفي متن الرواية أن يبين شوق حسان إلى الزمن الماضي زمن القيم الفاضلة والأخلاق النبيلة والرفيعة ويبين خيبة الأمل التي يشعر بها تجاه الزمن الحاضر زمن الانحلال الأخلاقي وانتشار السلوكات السيئة التي لا تمت بأي صلة للحضارة والدين الإسلامي، والسعي وراء السلطة والتخلي عن المسؤوليات الأخرى، فالحيرة تهز كيانه فيتلفظ لاماً ليدل من خلاله على العقبات التي لا تزال تملأ طريق العربي.
أما صوت الميم فهو موجود أيضا في العنوان الرئيسي وفي متن الرواية ، فالكاتب من خلال توظيفه للصوت يريد لنا أنه يبحث عن ذاته التي سرقت منه ويستعمل صوت الميم ليجمع أشلاء ذاته ويذكرها بمجد القدامى فحسان يتذكر الأمجاد التي صنعها علي البحراني وكيف يعمل من أجل أرضه ووطنه حيث يقول: «وراحت الكرات البيضاء تأكل الكرات الدموية الحمراء، وأنا أمسك بقبضة ياسين خوفا من الغرق، شعرت بأنهم وضعوا لي مواداً غريبة في أكلي».
ويقول أيضا: «حقل علي البحراني كان محروثا والشجر مقتلع، وثمة هوة عميقة تكاد تصل إلى النار، الزريبة مفتوحة وثمة ثلاث بقرات نافقات، لونها الأصفر الفاقع كان في الحلم».
كما وظف الكاتب أيضا:
الأصوات المكررة:
يقول ابن جني: «المكرر وهو (الراء)، وذلك أنك إذا وقفت عليه رأيت طرف اللسان يتعثر بما فيه من التكرير، ولذلك احتسب في الإمالة بحرفين ». فالراء من الأصوات المكررة وقد ورد بكثرة في متن الرواية وقد ارتبط ورود صوت الراء في هذه الرواية بمعنى التكرار والكثرة وهو يدل على تكرار وقوع حدث ما، فقد وظفه ليدل من خلاله على الحزن والألم الذي يعيشه، وأسفه على الواقع المتدني للمجتمع البحريني بصفة خاصة والعربي بصفة عامة، وتناسى القيم الفاضلة، والسعي وراء السلطة، وتحقيق الأهداف والمصالح ولو كان على حساب الآخرين والدوس على كل القيم الأخلاقية، فياسين يحقق مصالحه ونجاحه على حساب إخفاقات صديقه حسان، ومنه فقد جاء توظيف حرف الراء ليبين مدى عمق الألم وكثرة الأوجاع، فتكرار حرف الراء مرتبطة بكثرة الألم والوجع ودوام البحث عن التوازن الداخلي بمحاولته التخلص من الضغوط النفسية من اكتئاب وقلق إذ يقول: «صار شيئا مذهلا، عمارات كبيرة، وفنادق ومتاجر مثل الرمل وحشود غريبة من البشر، بالكاد أسمع كلمة عربي، أشعر بحزن هائل». فهنا يشعر بالحزن الشديد تجاه هذا الواقع المخزي.
ويقول أيضا: «الغرفة التي أعيش فيها شيء فضيع، مساحة محدودة وضجيج هائل يأتي من الخارج، وليس ثمة نقود، أحلم في ظلال مستمر، بتماثيل وبنادق ونيران تحرق كل شيء، لكن في النور ليس ثمة يد تمتد».
وفي الأخير نلاحظ أن لصوت الراء حضورا قويا في الرواية مما أضفى عليها شيئا من صفاتها كالكثرة والاستمرارية والدوام.
1- البنية الصرفية:
يعد الصرف من العلوم التي شغلت فكر علماء اللغة القدامى والمحدثين، بالبحث والتنقيب في أسراره وغاياته التعليمية التي توصل إليها الباحثون عنها استعملوا الأدوات اللغوية في الكشف عن خفايا النصوص الأدبية في الخطابات النقدية المعاصرة) ، وقبل الولوج إلى عملية تحليل البنى الصرفية بمدونة عبـــــــدالله خلــــــــيفة «التماثيل» لابد من التعريف اللغوي والاصطلاحي للصرف.
• الصرف لغة: معناه التغيير ومنه «تصريف الرياح» أي تغييرها.
• الصرف اصطلاحا: هو تغيير في بنية الكلمة لغرض معنوي أو لفظي.
وقد حصر البحث في هذه الأبنية على قسم واحد فقط هو:
– قسم الأسماء:
ما يميز اللغة العربية أنها لغة اشتقاقية تختلف عن بعض اللغات الأخرى وتشمل المشتقات (اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، اسم الزمان، اسم المكان، اسم الآلية ،اسم التفضيل، صيغ المبالغة، المصدر الميمي، المصدر الصناعي).
ومن هذا المنطلق سوف نركز على المشتق الأكثر ورودا في المدونة ألا وهو:
• الصفة المشبهة: هي وصف دل على معنى وذات وهذا يشمل اسم الفاعل، واسم المفعول، وأفعال التفضيل، فالصفة المشبهة تخالف المشتقات في الباء والمعنى فهي أقوى من الوصف وتصاغ من فعل لازم وتكون للحال. إن لحضور الصفة المشبهة «التماثيل» في العنوان انعكاسا على حضوره المكثف داخل الرواية فأخذ حيزا كبيرا منها .
إذ يقول في الرواية: «الأولاد نزلوا للأرض ونزلت معهم، هناك كان ثمة مدفن كبير أرينا تمثالاً ضخما لعبدالحسين وآخر لبتول ولكنها كانت حية وتسرح بالماعز وكانت أمي تساعدها وتثرثران طويلا».
ويقول أيضا:
«الفن حرام، هذه الصور الغريبة والتماثيل مفزعة وهي تأتيني من حيث لا أدري».
ويقول أيضا:
«كيف استطاعت عائلته في ذلك العتم الريفي أن تظم شابا مثل هذا؟، أهو سحر حراسة التماثيل المتوارث، أم بسبب هواجس الفقد والعزاء».
فالكاتب أراد من خلال توظيفه للصفة المشبهة أن يدل على ضعف حسان ومعاناته من الظلم والوحدة والخيانة وأنه على الرغم من كل ما اعتراه من قسوة واستبداد، فهو يبقى صامدا ومتحديا ينتظر المساندة.
2- البنية التركيبية:
يجدر بنا قبل الحديث عن البنية التركيبية بداية أن نتطرق إلى تعريف علم النحو على أنه: «علم ينظر في أحوال الكلمات إعرابا وبناءًا وبه يعرف النظام اللغوي للجملة كيف تتعلق الكلمات فيها لتؤلف تركيبا يحمل الإفادة».
وعليه فالبنية التركيبية أساسا هي الجملة التي تعد الوحدة اللغوية الرئيسية في عملية التواصل.
إذ يرى إبراهيم أنيس أن : «الجملة في أقصر صورها هي أقل قدرا من الكلام يفيد السامع معنى مستقلا بنفسه سواء تركت هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر».
ومنه نستنتج أن الجملة هي أصغر وحدة لغوية مفيدة، ولا يفهم منها قصد المتكلم إلا بحسن التأليف بين مفرداتها، فالبنية التركيبية هي المفتاح والأساس والعمدة التي تقوم عليها عملية التواصل، فعنوان الرواية هو جملة اسمية متكونة من مبتدأ محذوف زائد خبر.
ويعرب العنوان «التماثيل»: خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه التماثيل، إذ ترى أن الروائي قد اشتغل في هذا العنوان على المبتدأ فَحذَفَ المبتدأ كان اختصارا في موضع يحمل فيه الحذف والاختصار ويبدو أن للروائي أسبابه الخاصة التي جعلته يعتمد على الخبر كعنوان، كما أن هذا العنوان بوروده معرفة، والمعرفة: «اسم يدل على شيء معين»، وهنا أدت دلالة معينة وهي الجرح الداخلي الذي يعانيه الكاتب اتجاه الأوضاع الاجتماعية المزرية والانحلال الأخلاقي الذي وصلت إليه المجتمعات العربية عامة إذ نرى تضاد مع الواقع والمجتمع المتسلط، ولعل سبب تَفَرُد الخبر تعبيرا عن الوحدة والألم والضياع والوجع وتأزم الأوضاع الاجتماعية والسياسية.
ثالثا: وظائف العنوان
1/ الوظيفة الإغرائية:
تعد العناوين منطلقات حقيقة للقراءة بالنظر إلى نوع الحقيقة التي تؤديها داخل نسيج العمل التحليلي بالإضافة إلى وظيفة العنوان الرئيسية «إثارة فضول القارئ». وإثارة انتباهه واغرائه بعبارة محبوكة توحي بالتيسير لخلق نوع من الكلمات المثيرة للعنوان فتظهر بوضوح رغبة في التأثير في المتلقي، الذي يستقبل رسالة النص ومدى تجاوبه معها، وهذا ما تؤكده الدراسة في رواية «التماثيل» لعبـــــــدالله خلــــــــيفة، حيث غلبت هذه الوظيفة على مجمل الوظائف الأخرى، وتكمن إغرائية عنوان الرواية في اختيار الروائي المحكم والدقيق للعنوان حيث يختار العنوان بدقة وحذر متناهيين فالعنوان هو بمثابة فاتح الشهية يستخدمه الكاتب بغية إغراء المتلقي أو القارئ، فيرغمه على دخول عالم نصوصها المؤسسة على «استراتيجية إغرائية قادرة على شد انتباه القارئ وحمله على المتابعة رغبة في التواصل والاستكشاف».
فالوظيفة الإغرائية في الرواية تظهر من خلال السؤال الرئيسي الذي يعد بؤرة ومركزية هذه الوظيفة.
– ماذا يقصد الروائي بالتماثيل؟ وهل هي موجودة حقا أم هي من مخيلة الروائي؟
وانطلاقا من هذه الأسئلة تتضح جليا إغرائية العنوان، فهذه الأسئلة تعد رموزا تبحث عن تفكيك وسط زخم رواية «التماثيل» والتي ترغم المتلقي على الدخول إلى عالم النص.
2/ الوظيفة الإيحائية:
ترتكز هذه الوظيفة على الإيحاء غير المباشر لنص العنوان، حيث يصبح العنوان أكثر ترميزا وإيحاء ليشكل خطابا مفتوحا مشرعا على تأويلات مختلفة، فهي لا تعين العنوان ولا تصفه كل الوصف ولكن ألفاظها تجعل المتلقي يستكشف نوع النص والموضوع المنطوي تحته «ليعمل أفق المتلقي على استحضار الغائب أو المسكوت عنه أو الثانوي تحت العنوان». فنجد للتماثيل إيحاءات عديدة فكل يؤولها حسب تفكيره ورؤيته، فهناك من يفكر على أنها صور لأشخاص أو حيوانات مجسدة في شكل أصنام، وهناك من يرى أن، المقصود بالتماثيل هي الأصنام، التي كانت تعبد وهناك من يرى أن المقصود بالتماثيل هي تلك الثروات والخيرات التي تركها الأجداد، ومنه فإن للعنوان دلالات وإيحاءات مختلفة وذلك حسب رؤية وفهم وقراءة وتحليل كل شخص، فكلما تعددت القراءات اختلفت التأويلات.
3/ الوظيفة الوصفية:
قد تختلف هذه الوظيفة عن الوظيفة الإيحائية من حيث اعتبارها وسما مباشرا لمحتوى النص أو لجزء منه، لذا يرى بعض النقاد كـ”جيرار جنيت” يؤكد على أن العنوان «قد يؤدي الوظيفتين معا».
إن هذا التقارب أو التداخل بين الوظيفتين يجعل التمييز في عناوين عبـــــــدالله خلــــــــيفة أمرا يتطلب كثيرا من الدقة والحذر، إذ لا يمكن للقارئ الفصل بينهما إلاّ باتكائه على النص الذي هو المورد والحكم بين هذه العناوين فمثلا نجده في متن الرواية: «إنه كان طفلا نزقا كثير الحب للأكل وسرقة البيض والكعك من الدكاكين، لكن كان يظهر بغتة هادئا صامتا، وينزوي عند الشاطئ، ويتوارى في غرفته ويدمن القراءة فهذه كلها كانت علامات لدينا على الخبل». فهو هنا يصف ياسين وكيف كان مشاغبا يحب سرقة الأشياء كما نجده يقول:
«وانْتَبَهْتٌ إلى بدرية المرأة الجميلة الوجه الممتلئة الجسم لحد البدانة، فانشغلت عن الزميل الغائب»، فنجده هنا يصف بدرية وجمالها الفاتن الذي لم يستطع مقاومته، فهذه كلها أوصاف، مرة يصف ياسين، ومرة يصف بدرية.
4/ الوظيفة التعيينية:
تعد كل العناوين تحديدا لمضامين الرواية بدقة متناهية «وبأقل ما يمكن من احتمالات الّبس»”، فالمتلقي لا يمكن أن يتخيل انطلاقا من مضامين الرواية مخالفة لما جاءت به قريحة الروائي وهذا ما يجعل «العلاقة بين المتلقي هي علاقة تبليغية لرسالة لا تفهم إلاّ من قبل التذوق الذي من نفس مستوى الروائي». وهذا ما يتضح جليا في عنوان الرواية حيث نجد أن العنوان «التماثيل» موضوعها يدور حول قضايا اجتماعية وفكرية ينطلق منها لكشف أشكال الاستغلال الاقتصادي والزيف السياسي والتلوث الأخلاقي فالجميع أصبح يسعى إلى السلطة والنفوذ والوصول إليها بأية طريقة كانت حتى ولو كانت على حساب خسران وفقدان الأصدقاء مثلما حدث مع حسان وياسين فتخلى ياسين وخان صديقه حسان بسبب الرغبة في السلطة والنفوذ.
ونستنتج من خلال هذا الترتيب لوظائف العنوان في رواية «التماثيل» لعبـــــــدالله خلــــــــيفة سيطرة الوظيفة الإغرائية ومزجها بمختلف الوظائف الأخرى، وهذا التوظيف لم يكن استخدامه اعتباطيا، بل فعل ذلك لإبراز مدى جمالية العنوان، فالاغراء سمة من سمات العنوان، فهو ينبغي أن يكون مغريا حتى يؤدي وظيفته الأساسية المتمثلة في استكشاف النص و أيقاظ حب الاطلاع ويؤجج رغبة الكاشف.
خاتمة:
وفق النتائج المقدمة سابقا لهذه الدراسة، ومـن خـلال تسـلیط الضـوء علـى روایـة «التماثيل» لعبـــــــدالله خلــــــــيفة ودراستها دراسة سیمیائیة نخلص إلى النتائج التالية:
أن العنوان استطاع أن يثبت أنه علامة سیمیائیة وبالتالي كان المنهج المناسب لقراءة العلامة هو المنهج السیمیائي.
يعد علم العنونة علما دقيقا له مناهجه وضوابطه وآلیاته.
استطاع العنوان كمصطلح اكتساب معاني جدیدة استقاها مـن تعامله مع مختلف التخصصات.
تأتي أهمية العنوان من خلال دوره الفعال لعملية إنتاج القارئ لمعاني العمل الأدبي ودلالته، ويقوم بوظائف متعددة ومتنوعة.
بالإضافة إلى النتائج التي استخلصناها من تطبیقنا على الرواية وهي:
_ البنیة الأیقونیة: اتضح لنا أن كل من النصوص المصاحبة جمیعها أيقونات علاماتیة توحي بكثير من الدلالات وتعمل لتشكيل لوحة جمالیة ذات دلالات إیحائیة.
البنیة الصوتیة: لاحظنا سیطرة الأصوات التي توحي بالقوة لتلقي بظلالها على معنى النص.
_ البنية الصرفية: لاحظنا سيطرة الصیاغة الاسمية في الروایة.
_ البنیة التركیبـة: جـاءت معرفـة لأن العنـوان «التماثيل» جـاء معرفـة للدلالة علـى القوة.
_ تغلب الوظیفة الإغرائیة لأنها أكثر الوظائف نجاعة في استقطاب جمهور “القراء ” تليها الوظائف الإیحائیة فالوصفیة فالتعیینیة.
وبهذه النتائج والملاحظـات نرجـو فـي النهایـة أن نكـون قـد قـدمنا ولـو قـدرا یسـیرا ما یساعد على إثراء البحث، إذ هذه الدراسة ما هي إلا قطرة من بحر، نظرا لاتساع الموضوع وتشعبه ، ولا نستطيع أن نستوفیه ونعطیه حقه بدارستنا هذه.
October 5, 2021
عبـــــــدالله خلــــــــيفة : جذور الرأسمالية عند العرب
فصل من كتاب : رأس المـــال الحـكومــــي الشـــــــــــــرقي
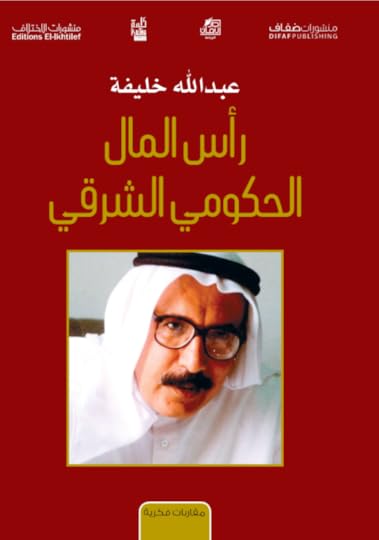
لا تسعفنا المصادرُ في الحديث عن وجود أو عدم وجود العمل المأجور ومدى حضوره في العصر الجاهلي والإسلامي الأول، رغم أنها مسهبة في تعداد الثروات الخاصة وظهور القطائع، وهي الشكلُ المبكرُ للإقطاع العربي، وتحدد العلاقات التجارية وطرقها والعلاقات الاجتماعية – السياسية المصاحبة لهذه التجارة، وكذلك تذكرُ الموادَ الأولية العربية والحرفَ المُقامة عليها، ومن هنا من الصعوبة بمكان معرفة طبيعة رأس المال الجاهلي – الإسلامي.
في البدء لا بد من معرفة المواد الأولية وهي السلع التي سوف تدخل السوق، وقيم هذه السلع، ومن أي عمل بشري أُنتجت، وماذا يحدث لهذه القيم في السوق، والأثمان التي يأخذها الوسطاء، ونوعية هذه السلع وأسباب نموها بهذا الشكل أو ذاك.
ومن الواضح بأن جغرافيا الجزيرة العربية هائلة، وأن ثمة مناطق زراعية متنوعة متباعدة، كاليمن وعمان والبحرين ويثرب – المدينة، والطائف الخ ، وهذه المناطق تفصلها عن بعضها البعض الصحارى الواسعة، وهي لا بد لها من إقامة علاقة تبادل بينها وبين بعضها البعض ومع العالم القريب كذلك.
إن الوقائعَ تشيرُ إلى عمليات تبادل تجارية بين هذه المواقع المختلفة، ويعبرُ التبادلُ عن وجود فائض اقتصادي، تمكنت قوى العمل الشعبية القبائلية من إيجاده، فقام وسطاءٌ هم تجار بإرساله للمناطق الأخرى فاغتنوا واغنوا التجار في المدن، ثم كانت مكة هي الوسيطة الكبرى التي نهضت فوق قوى العمل هذه حتى قوة تجارية عالمية.
كانت هناك مناطق ذات تاريخ قديم في الإنتاج كاليمن، ومن اليمن خرج اليهودُ إلى يثرب وأسسوا فيها الزراعةَ والحرف، كما خرجت قبائلٌ يمينة عديدة إلى يثرب وغيرها من المناطق خاصة شمال الجزيرة العربية، وتعبر قدرات اليهود في يثرب عن تعمق كبير في الجوانب الحرفية.
كانت سلع اليمن هي مثل: النسيج الفاخر، والذهب، والفضة، والأحجار الكريمة، ومواد التجميل، والتوابل بأنواعه ، والأسلحة وغيرها.
إن هذه السلع تدل على تجذر قوى العمل ومهاراتها المتنوعة، وإذ تشير إلى صلات تجارية بالخارج كالهند وأفريقيا، إلا أنها بضائع ومواد خام مستوردة تقوم قوة العمل اليمنية بإعادة تشكيلها ومن ثم تصديرها.
وتعبر مدينة يثرب عن هذا الطابع اليمني الحرفي المتأصل:
(أسس اليهود يثرب وعملوا الزراعة والحرف وصناعة السلاح والحدادة والدباغة والنجارة والصرافة وكان العرب يملكون 13 أطماً واليهود خمسين، وكان في المدينة أكثر من 300 صائغ حلي وكلهم من اليهود العرب وثمة حي اسمه حي الصاغة، (المال والهلال ، شاكر النابلسي ، ص 132)
وكانت المناطق الجزيرية الكبرى الأخرى كعمان والبحرين أقل من اليمن في التطور الحرفي بسبب التكون الحضري البعيد لليمن ومركزية حكمها، وعمان والبحرين تنتجان الموادَ الزراعية غالباً، مع ما يتبع هذه المواد من حرف.
إن هذا التكون التبادلي بين مناطق الجزيرة العربية كان يتبع الطريق التجارية الدولية أساساً، فهو يضخُ ما يزيد عن حاجتهِ إلى الأسواق الخارجية، فأغلب السلع الاستهلاكية الضرورية كالمواد الغذائية تـُستهلك محلياً، وما يزيد عنها وما يُخصص للبيع والتجارة يتوجه للأسواق المحلية ومن ثم المناطقية، وهي أسواق ثلاث كبيرة هي (عكاظ ومجنة وذو المجاز).
وتوضحُ طبيعة السلع اليمنية المُصَّدرة غلبة السلع الاستهلاكية البذخية، التي تباع لمركز التصدير ومن ثم تباع خارجياً، في حين يعيش أغلبية المنتجين على السلع الضرورية.
وبحكم تحول مكة إلى المركزين التجاري والديني معاً، فقد اختلطت السلعُ بالقيم الدينية. كانت المناطق الجزيرية العربية التي تقيم التبادل بينها بحاجة إلى سوق موحد تجري فيه أكبر عمليات التبادل، فكانت مكة التي تحولت من قرية إلى مدينة بفعل الخط التجاري الدولي المار بها، ومن ثم غدت المركز التصديري الرئيسي، فكان المنتجون لكي يستمروا في عيشهم بحاجة إلى تصدير الفائض نحو قبلة مكة التجارية، التي راحت تصير قبلة دينية كذلك ، بحكم إن الشعائرَ الدينية تحمي السلع والنقود الناتجة منها والعمليتان متداخلتان.
لكن المنتجين لم يفعلوا ذلك مباشرة، بل من خلال الوسطاء التجاريين، الذين كانوا يأخذون تلك السلع ويبيعونها، وفي البدء نيابةً عنهم بحكم النشؤ القبلي، ثم مع استمرار التمايز بين المنتجين والمالكين، انفصلوا وصاروا تجاراً مستقلين.
وتبينُ نشأةُ مدينة مكة هذا النموَ المتمايزَ للفئات التجارية من قلب العلاقات القبلية، ففي البداية نجد أن جد القبيلة (قصي بن كلاب) عنده أغلب وظائفها الدينية والتجارية مما عبر عن وحدة قبلية كلية في القمة، ثم تنشأ البيوتاتُ التجارية العائلية؛ كأمية وبني مخزوم وبني هاشم الخ .. مثلما تظهر العائلات الغنية والعائلات الفقيرة.
لكن الفارقَ بين مكة وبقية المناطق إنها غير منتجة لسلعٍ، بل هي تستقبلُ السلعَ وتصدرها، وتحتفظ بجزءٍ ضئيلٍ منها للاستهلاك، فهي بلا جذور حرفية وبلا زراعة، ومن هنا قامتْ بتحويل جزء من رؤوس أموالها لتملك الأراضي في المناطق المجاورة فكانت(الطائف) بستانها، و(جدة) ميناءها فغدت دويلة اقتصادية.
تعبرُ مكة عن المدينة التجارية الخالصة، التي لم تتطور من داخلها لتكون مدينة تجارة، بل هي قد أسستها الضرورة التبادلية العالمية والمناطقية، ولهذا فإن المناطق الأخرى لم تستطع أن تتطور مثل مكة في نموها الاقتصادي وفي عقليتها التحديثية.
لقد ساعدها غيابُ الجذور الزراعية والحرفية لكي تكونَ مدينةَ مالٍ وسلعٍ بالدرجة الأولى.
لكنها مع ذلك بحكم خلفيتها الدينية التي رُكبت وتصاعدت بفضل دورها التجاري التوحيدي، فكان هذا الدور يعضد المكانة التجارية ويضفي عليها قداسة، ولكن هي قداسة تجميعية للرموز الدينية مثلما هي تجميع للسلع التجارية.
ومع ضخامة دور الوسيط بين المنتجين المتوارين، سواء كانوا عرباً أم أجانب، فإن الوسيطَ هو الذي أثرى أكثر من أولئك المنتجين، وتدلنا الأرقامُ التجارية للسلع ولأرباحها عن ضخامة الرأسمال البضائعي الذي يتدفق والذي يتحول من جديد للتجارة، أو يشتري الأرض العقارية، التي كانت محدودة بحكم ضخامة الصحراء.
ومنذ البداية نلمح هذا التناقض الهام بين كمية النقد الكثيرة المتوفرة وغياب التوظيفات الفاعلة، فيذهب قسمٌ كبير من النقد نحو الاستهلاك البذخي، فيضيع من دورة رأس المال، ولكنه في هذه المرحلة لايضيع بل يوظف لكن حين ستنشأ أسرٌ حاكمة ويتراكم الفائضُ لديها فسوف يتجه إلى البذخ الخالص.
كان في جزيرة العرب طريقان للتجارة (أحدهما شرقي يصل عمان بالعراق وينقل بضائع اليمن والهند وفارس براً، ثم يجوز غرب العراق إلى البادية حتى ينتهي به المطاف في أسواق الشام) (والطريق الثاني هو الأهم وهو غربي يصل اليمن بالشام مجتازاً بلاد اليمن والشام ناقلاً أيضاً بضائع اليمن والحبشة والهند إلى الشام وبضائع الشام إلى اليمن حيث تصدر إلى الحبشة والهند عن طريق البحر)، (كتاب أسواق العرب، ص9).
من المدن التجارية الهامة في العصر القديم (تيماء: المحطة الكبرى العامة شمالي الحجاز مروراً بسلع وبُصرى وتدمر ودمشق).
(كان للعرب دراية بالملاحة منذ القرن العاشر قبل الميلاد)، (عن تاريخ العرب الأدبي نيكلسون) ويضيف: (وكانت صعوبة الملاحة في البحر الأحمر تجعلهم يفضلون الطريق البري).
(كانت القوافل تقوم من شبوت في حضرموت وتذهب إلى مأرب عاصمة سبأ ثم تتجه شمالاً إلى مكربة (مكة) وتظل في طريقها من بترا حتى غزة).
(كان الحميريون هم المسيطرون على التجارة جاعلين العرب الحجازيين عمالاً عندهم حتى قبيل البعثة) (السابق ص 11).
(منذ القرن السادس انتقلت التجارة تدريجياً من اليمنيين إلى قريش).
قال الألوسي:
(وأما أهل اليمن وعمان والبحرين وهجر فكانت تجاراتهم كثيرة ومعايشهم وافرة لما في بلادهم من الخصب والذخائر المتنوعة والمعادن الجيدة)، ص 11(على أن لطيئ ومنازلها أواسط نجد شهرة في الاتجار شمالي جزيرة العرب).
(وقدّر بعضُهم ما يشتريه العالمُ الروماني من طيوبِ بلاد العرب والفرس والصين بقيمة مائة مليون من الدراهم) ص 12.
وتعبيراً عن التبادل المناطقي الواسع قالوا:(برود اليمن وريط الشام وأردية مصر).ومن أقوالهم:(الطائف مدينة جاهلية قديمة وهي بلد الدباغ يدبغ بها الأهب الطائفية المعروكة). أما(هجر والبحرين فهي متجر التمر الجيد).
كان التجار يُسمون السماسرة فجاء الإسلامُ بكلمةِ معشر التجار. وهناك اسماء أعجمية وَرَدتْ للعرب تحملُ أسماءَ البضائع:(الصنج والصولجان والفيل والجاموس والمسك وخصوصاً أنواع النسائج كالديباج والاستبرق والابرسيم والطيلسان) السابق ص 18.
وتعرفنا بعض الكلمات الأعجمية التي عربت وصارت جزءً من التسميات العربية على تغلغل العلاقات البضائعية في الحياة الجاهلية مثل:(ترف وجزية ودرهم وفندق وقارب ولص).سردَ هذه الكلمات بندلي جوزي في بحثه (بعض إصطلاحات يونانية في اللغة العربية) في مجلة مجمع اللغة العربية 3 / 330 نقلاً عن المصدر السابق، ص 19).
قال معاوية لصوحان صف لي الناس فقال: خلق الناس أخيافاً، فطائفة للعبادة، وطائفة للتجارة، وطائفة خطباء، وطائفة للبأس والنجدة، ورجرجة بين ذلك يكدرون الماء ويغلون السعر ويضيقون الطريق.
وقد عرف العربُ سندَ الملكية(طابو) والعقود.
ومن كتاب المحاسن والأضداد نقرأ( إن العديد من رؤوساء قريش كانوا باعة وحرفيين). وتعددت البيوع عندهم مثل: بيع الغرر، أي بيع ثمر النخل والشجر لمدة عام أو عامين وهو مرفوض دينياً.
بيع التصرية وهو عدم حلب الناقة لفترة من أجل أن تمتلئ وهو شكل من التحايل.
البيع الناجز وهو البيع الصحيح يداً بيد.
(في البدء كانوا يتعاملون بالمقايضة ثم تعاملوا بنقود الروم والفرس، الدنانير والدراهم، ويقدر الدينار بعشرة دراهم، والدرهم يساوي عشرة قروش مصرية ( حسب زمن المصدر 1960)
ويدل هذا على ضعف تطور العلاقات البضاعية – النقدية، ثم نموها عبر تنامي إنتاج القبائل عبر مئات السنين، واستمرار سيطرة الفرس والروم السياسية، فكان فائضٌ ما ينتقل من الجزيرة للأمبراطوريتين، ثم غدت نقودهما نقودَ الأمبراطورية الإسلامية التي وورثت الهيكل الاقتصادي – السياسي العبودي – الإقطاعي دون أن يستطيعَ التراكمُ المالي أن يؤدي إلى المرحلة الرأسمالية.
وجاء لدى المقريزي إن أول من ضرب السكة عمر بن الخطاب على نقود فارسية مع كلمات عربية إسلامية.
وكان لديهم (المكس) وهو أخذ العشر من بائعي السوق والمكس في اللغة النقص وفي البيع انتقاص الثمن. قال الشاعر:
أفي كل أسواق العراق أتاوة/وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم
وحول الاستغلال وتراكم الأموال، جاء في خزانة الأدب (كان أحيحة بن الجلاح كثير المال شحيحاً عليه يبيع بيع الربا في المدينة).
عُرف بعض الصحابة باستخدام الربا كخالد بن الوليد وعثمان بن عفان وحين جاء الإسلام تركا الربا بطبيعة الحال، وكان الرهن يصل إلى رهن البشر مما يعبر عن كوابح تطور العلاقات البضائعية النقدية وانغمارها بعلاقات العبودية وقتذاك.
وهناك ربا الأضعاف المذموم بشدة في القرآن ((لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة)) آل عمران 3، وهو أمرٌ يعبرُ عن هدف سياسي هو زعزعة سيطرة القبائل اليهودية على المدينة وعلى العرب وقد أخذ الفقهاءُ هذا الحكم كحكمٍ مطلق وليس نسبياً، ثم جاء فقهاءٌ حاولوا تجاوز هذه الإشكالية عبر ما ُسمي بفقه(الحيل). وهذا كله يبين استمرارية تنامي العلاقات البضائعية النقدية لدى العرب رغم الكوابح الطبيعية الهائلة والشظف والتحكم السياسي الجائر في عصور الدول الاستبدادية.
لم تستطع العلاقات المالية والبضاعية كشكلٍ أولي من العلاقات الرأسمالية أن تحصل على مساحة أساسية في البناء الاجتماعي العربي الجاهلي، بسبب ضخامة العلاقات الأبوية التي تتمظهرُ في سيطرة شيوخ القبائل على أجسام القبائل في حركاتها الانتقالية المكانية وفي توجههاتها، عبر الحفاظ على البناء الاجتماعي التقليدي القائم على خضوع الفقراء للأغنياء والصغار للكبار والنساء للرجال والعبيد للسادة.
وهذا كله يؤدي لعدم ظهور وتراكم الرأسمال.
وتلك سيطرة اجتماعية موجودة في كل القبائل، لكن لم يكن لرؤساء القبائل مركز سياسي ما، فجاءتْ الدولةُ العربية الإسلامية لتضعَ الأسسَ لانتقال سيطرتهم الاجتماعية لتكون سيطرة سياسية بعد هزيمة دولة الجمهورية الشعبية زمن الخلفاء الراشدين.
وتلك السيطرة الاجتماعية على كل قبيلة منفردة، توحدت بالنظام السياسي الأمبراطوري، الذي كرسَّ سيطرة زعماء القبائل، وأشركهم في المداخيل واستعان بهم في الجيوش والحروب الخ..
وبهذا فإن العلاقات المالية البضاعية في زمن الجاهلية لم تحصل على بنية اجتماعية مُستوعِبة لها، بسبب ضخامة الصحارى وتشتت القبائل والمدن.
فبقيت العلاقاتُ الرأسماليةُ الجنينية على ضفاف العلاقات الاجتماعية الأبوية وحين تكونت المدنُ الإسلامية الأولى خاصةً، كالبصرة والكوفة والفسطاط والقيروان وفاس فإنها كانت معسكراتٍ للجيوش، مما جعلها مراكزَ سياسية بدرجة أولى، ثم تحول بعضُها إلى مدنٍ تجارية كبيرة لأسباب خاصة بها كالبصرة التي غدت الميناء الكبير على ضفة الخليج.
أما السيطرة الاقتصادية الكبرى على الثروة والإنتاج فكانت من نصيب نفس تكوين الشيوخ القبليين في زمن الجزيرة الجاهلية، ولكن صارت سيطرتهم مركزةً في أسرة واحدة وفي شخص الخليفة، وغدت الأملاكُ الكبرى الزراعية هي الأساس الاقتصادي للدولة، ومن الخراج و مكوس التجارة تتشكل أغلبية الدخول.
تغدو الملكية الزراعية الإقطاعية هي ملكية عقارية غير داخلة في التداول البضائعي بشكل عام، لأنها بعضها يُوهب أو يُباع، ولكونها هي مصدر أغلبية الثروة الأساسية فإن (المجتمع) يكون قد أعاق نمو العلاقات البضائعية بطريقة سياسية مخربة على المدى الطويل.
إن الملكية العقارية الكبرى هي بضاعة في ذاتها لكنها مملوكة للإدارة السياسية فتتجمد وتعرقلُ تطورَ السلع ونموَ رأس المال، وهي كذلك وسيلة من وسائل إنتاج البضائع، عبر تحول مداخيلها عند الأسرة الحاكمة وأسر الكبار عموماً إلى وسيلة اكتناز وبذخ، فتغدو مصدراً لحراك اقتصادي يؤدي مع مرور السنين إلى الأفلاس، لأن المداخيل (أو الجزء الأكبر منها) لا تعود لبنية الإنتاج.
إن الطبقات والفئات التي تستولي على النصيب الأكبر من الفائض الاقتصادي تدرجهُ في الاستهلاك الشخصي، فسواءٌ كان ذلك لدى الخلفاء وزوجاتهم وابنائهم أم لدى التجار الكبار والقواد وكبار رجال الدين الحكوميين، فإن الفائض لا يعود مرة أخرى لتطوير الإنتاج إلا بنسبة ضئيلة كترميم السدود.
وسنجد بعض مظاهر تدهور رأس المال التجاري كالهجوم على أموال كبار التجار وقيام هؤلاء بإخفائها تحت الأرض، والسطو على أموال الخلفاء أنفسهم وسرقة مصاغ زوجاتهم، في حين إن الوضع الاقتصادي العام يشير إلى الخروج المستمر للذهب من الديار الإسلامية، وتدهور قيمة العملتين الذهبية والفضية، وتدني وتدهور الحاصلات الزراعية، وجمود الحرف بسبب عدم تغلغل الرأسمال المادي والعلمي بها، فتغدو الحرف عاجزة عن التحول للصناعة، بل تصيرُ مهناً تقليدية يسيطر عليها أسطوات ومعلمون يحولون طرق الإنتاج فيها إلى أسرار، ويحولون الشغيلة إلى تلاميذ. وهذا ما يكون مناسباً في مستوى الثقافة مع الثقافة الصوفية التي تغدو هنا طرق دراويش مخلوطة بسحر وخزعبلات.
هكذا فإن رأس المال يغدو على ضفاف المجتمع الإسلامي، سواء بتدميره على مستوى الطبقة الحاكمة بالبذخ، أو على مستوى الشغيلة بتحجر الإنتاج وتدهوره المستمر.
ولكن بين التوسع الكبير للإنتاج الزراعي وضخه للموارد في المدن وبين انهياره ثمة قرون من التطور الاقتصادي الذي تظهر فيه إبداعات اجتماعية وثقافية كثيرة.
ونستطيع أن نرى تبايناً في علاقات الإنتاج والتداول، فثمة علاقات عبودية جزئية وإقطاع سياسي متحكم بشكل عام، وعلاقات رأسمالية غير سائدة تتمركز في التجارة خاصة.
وإذا حدث تناغمٌ بين الإقطاع السياسي والعلاقات الرأسمالية، بمعنى عدم قيام الإقطاع الحاكم بتضييع الثروة وساهم بفتح المجال لنمو التجارة والحرف، أي بتطوير مصادر الإنتاج، فإن العهدَ يشهد ازدهاراً، كما حدث في بعض فترات الحكم الأموي أيام معاوية وعبدالملك بن مروان، ثم في الدولة العباسية لدى المنصور وهارون الرشيد والمأمون، ولكن مع تفاقم نفقات الحكم والجيش فإن ذلك يؤدي لتدهور مصادر الإنتاج، وقيام فترة الاضطرابات و مجيء الحكام الضعاف وتدهور الثقافة الخ، كما نلحظ ذلك مع حكم المعتصم العسكري البذخي ثم تنامي التدهور في الخلفاء من بعده، وتؤدي الحروب دور المعجل للتفسخ والتجزؤ للأمبراطورية.
وقد أوضحنا كيف إن هذه العلاقات التجارية والمالية ازدهرت بشكل واسع، وعرفت كل أشكال التبادل التجاري والمالي، بين المناطق العربية الإسلامية وبينها وبين العالم.
وإذا كانت هذه العلاقات لم تصل إلى إزاحة البناء الاقطاعي، أي هيمنة الأسر على المال العام والإنتاج، فإنها نقلتْ جوانبَها المتقدمة إلى القارة التي سوف تتفتح فيها هذه العلاقات التجارية المالية على أوسع مدى وهي القارة الأوربية.
وبعكس الآراء الزاعمة بقيام العرب بخلق التخلف الأوربي فإن المعطيات التاريخية الموضوعية تشير إلى العكس أي قيامهم بخلق أسس النهضة على مستويي الاقتصاد والثقافة.
وهكذا فإن درجات التطور الرأسمالي العالمي لها حلقات مشتركة من الأدنى إلى الأعلى وبالعكس، فبعد التدهور الاقتصادي الذي جرى في أوربا خلال القرنين السابع والثامن الميلاديين، ظهرت الدويلات الإقطاعية الصغيرة وصارت الكنيسة الكاثوليكية أكبر مالك للأرض الزراعية وتحكمت الجيوش والأنفاق الهائل عليها مما زاد من الضرائب التي أضعفت الإنتاج.
ووقع الاحتكاك العربي الأوربي الاقتصادي الإيجابي في حوض البحر الأبيض المتوسط، ومن هنا نرى أن المناطق الداخلية والغربية الأوربية عرفت النهضة لاحقاً، وتركزت النهضة في المدن الإيطالية القريبة من الممالك العربية، ورغم إن الرأسمال التجاري الإيطالي تشابك بقوة مع الحملات الصليبية التي استثمرها إلا أنه تنامى أكثر بفضل نمو التجارة السلمية، فسك العملات النقدية الجديدة وأسس الشركات، وغيّر نظامَ الأرقام مدخلاً نظامَ الأرقام العربية وترجم ونقل الكثير من جوانب العلوم الطبيعية والرياضية والفلسفية العربية، وكل هذه الخميرة انتقلت إلى الدول الأوربية في الوسط ثم في الشمال والغرب، والأخيرة هي التي قامت بالثورة الصناعية والرأسمالية الشاملة بفضل ابتعادها عن مركز الإقطاع في روما وازدهارها بالتجارة والاكتشافات الجغرافية.
بطبيعة الحال فإن قانونَ النمو داخليُّ دائماً لكن المؤثرات الخارجية الإيجابية تسرعُ من الصراعات الداخلية باتجاه التقدم، ولم يستطع الرأسمال الصناعي الظهور في غرب أوربا إلا بتراكمات هائلة أوربية وعالمية، حيث عملت التدفقات النقدية والمعلومات العلمية وحرية بعض المدن على هدم الجدار الكبير بين الحرف والصناعة، أي عبر خلق نظام المحركات في إنتاج السلع: (المانيفكتورة ثم المعامل). وهو أمرٌ عجز عنه العرب للأسباب السابقة الذكر. وبهذا التحول تم ظهور نظام الرأسمالية العالمية ومنشأه أوربا الغربية.
إن وجود مناطق حرة لظهور الرأسمال الصناعي، حرة من حيث عدم تسلط الحكومات ورجال الدين المحافظين، قد تشكل في المناطق البعيدة عن المركزيات المتشددة، وعبر خلق سوق قومية الخ..
ولكن مع تحول الرأسمالي الأوربي القاري – العالمي، فإن السيطرة على المواد الخام والأسواق الخارجية صارت معرقلةً لنمو الرأسماليات في الدول المتخلفة، فقام الغربُ بالتحكم في أسواق الدول العربية والإسلامية، مانعاً إياها من العملية التي ساهمتْ هي فيها وأسست تقدمه، أي أنها كونت مرحلة الرأسمال التجاري التأسيسية، فوضع الغربُ الأمبريالي اثناء سيطرته الأولى القيودَ الكثيرة على بقاء الدول العربية والمختلفة عامة في مرحلة الرأسمال التجاري دون المساح لها بالصعود إلى مرحلة الرأسمال الصناعي. فعاش الشكل الأعلى وهو الرأسمال الصناعي(الحر) أكثر من قرن على التحجيم والقيود.
فحين جاء الاستعمار الغربي لم يعمل على تغيير البناء الإقطاعي الموروث بل حافظ عليه ووطده. بأن جعل الحكام يحصلون على قسم كبير من الثروة من خلال التحكم في أجهزة الدول، وهو الأمر الذي حافظ على البناء الإقطاعي القديم، بكل بنيته الاجتماعية، وكان الحكام هم الغربيون ثم سلموا الحكم للقوى المحلية التي جُيرت لخدمة البناء الاقتصادي التابع.
وهذه العملية الاقتصادية العالمية المتضادة، أي دفع العرب أوربا للتقدم ثم دفعُ الغربِ العربَ للتخلف، تعكس طبيعة النظامين العالميين الإقطاع والرأسمالية، في مرحلة النشأة الأولى العالمية للنظام الحديث، وهي تعكس مستوى قوى الإنتاج على الجانبين، فالنظام الأول العربي يقومُ اقتصادياً على الخراج والمكوس والغزو(وهو شكل من الاستيلاء المباشر على السلع)، في حين يقوم النظام الثاني الغربي على تصدير رأس المال والسيطرة على الأسواق. فكان من الطبيعي أن يحدث تصادمٌ كبيرٌ ومأزقُ بين التشكيلات الاقتصادية البشرية الكبرى.
وهذه المرحلةُ من العلاقة بين الإقطاع الشرقي والرأسمالية الغربية هي مرحلة أولى لأن مراحل أخرى ستتشكل تبعاً لتبدل قوى الإنتاج الغربية وتطور الدول الشرقية كذلك، فتغدو التشكيلة الرأسمالية عالمية تزيل التشكيلات التي كانت قبلها بشكلٍ تدريجي.
لقد ابقت الرأسماليةُ الغربية الدولَ العربية في البناء الإقطاعي و(تطوراته) ويظهر ذلك في الحفاظ على طبيعة الحكم السياسي الذي يغدو مالكاً لقسم كبير من الثروة عبر الجهاز الحكومي، وهو الجاب الذي يمثل استمرارية للدول السابقة الأموية والعباسية والطوائف، فهنا لم يحدث قطع بنيوي، ولم تجعل الدول الغربية السيطرة الدول العربية على نموذجها بل أبقتها في الماضي، في ذات التشكيلة الإقطاعية، فصارت التطورات المالية والتجارية القديمة والمحدثة تجري في البناء القديم لأسباب سياسية واقتصادية عميقة.
يتحدد تاريخ البشرية في القرن العشرين بصراع الرأسماليات الغربية الكبرى القوية برأسماليات الشرق النامية الضعيفة، وقد قُيض لرأسماليات الشرق أن تبرز روسيا كقوة طليعية عالمية لها، وبطبيعة الحال وبسبب مستوى الوعي، أُعتبر ذلك صراعاً بين الرأسمالية والاشتراكية، وأعطى الشكلُ الذي ظهرتْ بهِ الرأسماليةَ في روسيا كشكلٍ رأسمالي حكومي التباساً في فهم العملية التاريخية، لكن كان ذلك إبرازاً لسببية أقوى هو دور الدولة في الشرق الحاسم في عمليات التحول الاقتصادية.
لقد كان بروز الدولة في هذه العملية التاريخية إستعادةً لهذا الدور القديم الراسخ، ولكن جرى هذه المرة في سبيل إحداث قفزة اقتصادية كبرى، أدت إلى خلق القواعد الرأسمالية الحقيقية للاقتصاد عبر التركيز على الصناعة الثقيلة المحورية في حدوث الانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية، مع يترافقها من عمليات تحديث اجتماعي وثورة ثقافية ومساواة قانونية للنساء بالرجال، وبالتالي قربت هذه العملية التاريخية الكبرى روسيا من مصاف الدول الرأسمالية الكبرى في غضون نصف قرن، إذا تغاضينا عن الحروب التي شُنت على روسيا والمقاطعة الاقتصادية والعلمية، وكان لذلك ثمن باهظ لكن العملية أُنجزت، كما قامت روسيا كذلك بجعل تجربتها عالمية عبر الصين وفيتنام وأوربا الشرقية الخ..
ثم انضمت دولٌ عربيةٌ إلى هذه التجربة بدون ذلك الحسم السياسي، وهو قوة الدولة في تغيير الهياكل الإقطاعية وإحداث القفزة الكبرى بسحب الفائض الاقتصادي من مسام المجتمع كله وتوجيهه نحو الصناعات الكبيرة والعلوم.
وإذ استطاعت دول روسيا والصين وشرق أوربا من تحقيق معدلات تنمية غير مسبوقة بشرياً، فإن دول العالم الثالث الأخرى ظلت تراوح في مشكلاتها وتخلفها وتجرجر أذيال الماضي كامعاء لا تـُدفن، لكن ذلك لا يعني عدم حدوث أخطاء كبيرة في التنمية.
فقد عملت التجربة على تملك كل أشكال الملكية الخاصة دون تفريق ونظرة بعيدة المدى، فصادرت الأملاك الإقطاعية الأسرية والدينية أولاً، ثم الملكيات الصناعية والتجارية ثم توجهت لأملاك الأرض المتوسطين ومن ثم الصغار، مما حول الدولة إلى المالك الوحيد، باعتبار أنها ستكون جسراً نحو الملكية الشيوعية المفترضة، أي أن هذه الملكية العامة ستلغي نفسها، وهو عكس التصور الشيوعي الأصلي الذي يقول بأن الملكيات العامة الناتجة من تطور تقني هائل، لن تحتاج إلى دولة لتشكلها بل أن الدولة نفسها ستذوب وتغدو إدارة الاقتصاد ذاتية من قبل المنتجين وإداراتهم، فيغدو التصور(الإشتراكي) الروسي مطابقاً لرأسمالية قومية، تقوم بتضخيم الدولة وتسريع العملية الاقتصادية، وهو ما قلنا بأنه يتماشى مع الجذور الاستبدادية الشرقية في عملقة الدول وتحكمها، وهذا ما أدى إلى قدرة هائلة على السيطرة على الفوائض الاقتصادية وتوجيهها إلى الصناعة الثقيلة، وعبر تقشف وزهد ثوري خاصة في البداية، وتوسيع المشاركة الشعبية والحزبية إلى اقصى حد في التنمية ومراقبتها، وبدون هذا التلاحم الشعبي والحزبي والقتالية الثورية التي تشكلت خلال هذا الوهم الإيديولوجي بتشكيل الاشتراكية وإذابة الفروق إلى الأبد بين الأغنياء والفقراء، وعدم العودة للاستغلال، ما كان للتضحيات الشعبية أن تتشكل.
ولكن حدثت المعجزة بشكل آخر وهو انضمام الدول الشرقية الكبرى إلى النادي الرأسمالي الغربي، في حين أن الدول العربية التي ماشت هذا الوهم الإيديولوجي ماشته بكثير من التردد والخوف، فقد عارضت مصادرة الملكية الإقطاعية السياسية والدينية، رغم أنها هي الأخرى كانت تعبيراً عن دكتاتورية شعبية لكن هذه الدكتاتورية لم تلبس ملابس الدكتاتورية الطبقية المفترضة، فهي خائفة من دهسها من قبل هذه الدكتاتورية، وهكذا كان قادة المعسكر (الاشتراكي) قادمين من صفوف العمل السري الطويل ومن الحروب الأهلية ومن بين العمال والفلاحين، لكن قادة (الاشتراكية) العربية كانوا عسكريين بيروقراطيين، فعجزوا عن الحسم مع الملكيات الإقطاعية والإرث الإقطاعي الاجتماعي والديني، فوجهوا ضرباتهم الاقتصادية إلى البرجوازية الصناعية أولاً، في حين تركوا الوسطاء من مقاولين ومن صيارفة ومن ملكيات زراعية كبيرة، وتركوا القوى العمالية الفائضة دون حشدها في قوة العمل الاجتماعية، فاستمرت قوى الهامشيين كالعاطلين واللصوص والشحاذين والمومسات بشكل واسع، وعجزوا عن دمج أكبر قوة مهمشة في الإنتاج الاجتماعي وهي النساء، وكان من ثمار هذه السياسة(الإشتراكية) عدم بناء الصناعة الثقيلة فاستمرت نفس الهياكل الاقتصادية المتخلفة مع بعض التطور في الصناعة المتمثل في بناء بعض مصانع الحديد والصلب وغيرها من المنشآت كمنشآت الري، هي الحدود التي بلغتها مثل هذه التنمية التي رفضت تشكيل الصناعة الثقيلة، بدعوى عدم التضحية بالجيل الراهن، وما لبثت أن تنامت سوسة البيروقراطية والفساد في هذه الملكية العامة نفسها، فقلصت إيجابياتها أو جعلتها في خدمة قوى الطفيلية المتصاعدة.
وفي حين أن الدول الشرقية (الاشتراكية) قد عانت فيها الصناعة الخفيفة المهلة، وأدت البيروقراطية إلى شلل تقني وإلى العجز عن ملاحقة الثورة المعلوماتية والعلمية، بعكس ما كانت تنادي به الاشتراكية في أدبياتها الأولى، لكن الصناعة الثقيلة قد شكلت، وتغلبت في أحيان عديدة على مستويات بعض الدول الرأسمالية الغربية. أما الدول الاشتراكية العربية فهي ضيعت الصناعتين فلم تجذر صناعة ثقيلة ولا خفيفة، وكان من جراء ذلك ما سُمي بـ(الانفتاح) وهو القضاء على الصناعتين معاً وترك الاستيراد يستولي على السوق الوطنية.
ودليل ذلك يظهر في السلعة، حيث لا توجد سلعة مصنعة عربية هامة، في حين إن الدول الشرقية (الاشتراكية) تمكنت من تصنيع سلع كبيرة رغم أن المواصفات ليس بجودة السلع الغربية تماماً، لكنها في الطريق لكسب معركة الجودة والنوعية.
وهذا يعني أن الطبقة الإدارية التي لبست عباءة الاشتراكية في الشرق إعادت تشكيل قوة العمل البشرية لتلائم الاقتصاد الحديث، وحافظت على خلق سوق وطنية كبيرة محمية، ووجهت الفوائض الاقتصادية نحو معركة التغيير الاقتصادي الحاسم، وغيرت البنية الاجتماعية الشعبية المحافظة التقليدية لتلائم سوق العمل العصري في حين لم تفلح ذات الشريحة في العالم العربي القيام بذلك.
يقوم المضمون الإقطاعي العربي الموغلُ في القدم بدمغ أية ظاهرة واردة من الخارج، فيحيلها إلى هيكليتهِ ويمتصُ حداثتَها في تخلفه، ورأسامليتها في إقطاعيته.
فامتيازاتُ النفط وواردته تقسم بين الشركة الغربية والعائلة الحاكمة أو قيادة الحزب أو قيادة الدولة، فبدلاً من أن تكون ملكية النفط إنتاجية خاصة أو تابعة لدولة ديمقراطية، تصبحُ ملكاً لأطراف سياسية متنفذة، تعكس مصالح الطبقة المسيطرة في البلد المعني.
وفي حين يخصص قسمٌ صغيرٌ للخدمات ومصالح الدولة العامة تقوم ذات القوى المحلية المهيمنة وحلفائها في الإدارة بشفط قسمٍ آخر منه ذلك التقسيم الثنائي؛ غربٌ مستكشفٌ مستورد، وشرقٌ منتجٌ مالك، وهي تسمياتٌ على غير مسمى.
هكذا يقوم الإقطاع بتحويل ملكيةٍ رأسمالية حديثة إلى ملكية إقطاعية أساسية، في موارد الإنتاج الكبرى، ثم تجري كل العمليات الاقتصادية الفوقية بطريقة رأسمالية من تحديد للرأسمال الثابت أو المتغير وأسعار المواد الخام وبيعها، ولكن المضمون الأساسي، وتحديد أساسيات الدخل، تتم من خلال عوامل سياسية مسيطرة على العلاقات الاقتصادية، وهو أمر لا يختلف عما حدث في العصرين الأموي والعباسي.
وهذا يندرج على الاصطفافات التجارية وطبيعة العائلات التجارية التي تتشكل من خلال قرارات سياسية عليا، عبر تشكل علاقات سياسية معينة بين الطبقة المسيطرة وهذه العائلات التجارية، فيجري السماح لعائلات معينة أو منع عائلات معينة من التجارة أو من الدخول إلى البلد، أو إعطاء جنسيات معينة حق مزاولة مهن مهمة، كما حدث للعائلات الأوربية المهاجرة في بعض الأقطار العربية ومنحها أمتيازات لا تـُمنح لمهاجرين آخرين.
وتقوم العائلة المالكة للأرض والعباد أو المكتب السياسي للحزب الحاكم أو هيئة الضباط المتنفذة، بتقريب أو إبعاد الموظفين الكبار وتحديد بناء الوزارات والإدارات تبعاً لمصالحها ونفوذها ومداخيلها.
بل حتى الموظفين الصغار يتأثرون بالسيطرة الإقطاعية على أجهزة الدولة، فهي ترتبُ الدوائرَ لخلق صراعات مذهبية أو دينية أو قومية وتكون خالية من الأفكار المناوئة لها، وتخفض الرواتب هنا من أجل ضبط السيطرة وخلق االفئات الدنيا المحتاجة.
وإذا كان المضمون الإقطاعي هو المشكل لجوهر الملكية العامة فالطلاء الغربي الخارجي يكون متحداً بذلك المضمون، عبر المظاهر الحديثة والأشكال المحاسبية الغربية، لأن السلعة الخام لن تبقى في البلد المعني، بل سوف تكون من نصيب البلد الغربي، فليس مكان الإنتاج سوى مكان عابر، في حين يكون البلد الغربي الرأسمالي هو المكيف للسلعة من أجل حاجته ومشروعاته وتطوره. فيغدو البلد(المستورد) هو المنتج، ويصير المشتري هو المتحكم في عملية البيع.
يغدو مكانُ إنتاج السلعة ضمن النظام الإقطاعي المحلي مستهدِفاً لغاياتٍ سياسية بارزة، أهمها استمرار تدفق المادة الخام الثمينة، كمادةٍ خام أو كمادة محوَّلة بعض التحويل، في حين تبقى العمليات التقنية والاقتصادية العميقة من اختصاص البلد المستورد، وهذه التحولات العميقة هي التي تبقي البلدُ المتطور مسيطراً ورأسمالياً في حين تبقى البلدُ المصدرُ إقطاعيةً تابعة.
وإذا حدثت تطوراتٌ رأسمالية في البلد المصدر فإنها تبقى رأسمالية فوقية أو سطحية لا تصل إلى تصنيع المادة الخام إلى اقصى مدى.
وليست المادة الخام ثمينةً إلا لظروف اقتصادية تاريخية تتعلق بأهميتها في بلد الاستيراد المُسيطر، وليس في البلد المُصدر، فمن اكتشفها أو زرعها وخلق شبكة إنتاجها المحلية وشبكة توزيعها الدولية هو البلدُ المستورد، لظروف اقتصادية مرحلية تتعلق بتطور قواه المنتجة، ودور السلعة المستوردة البارز في هذا الإنتاج، وحين تُشاع مثل هذه السلعة أو تحل محلها بدائل كالقطن الذي نافسه الحرير والنايلون والقماش العادي، فإن نظام الاستيراد المسيطر يتغير.
ولا تقتصر قوى نظام المستورد المحلي على الطبقة الإقطاعية المالكة أو المشاركة في الملكية، بل على قوى تقدم مساندة مالية وخدماتية وعملية للمشروع، كالمقاولين الذين يستأجرون عمالاً أو يبيعون مواداً مفيدة للمشروع، أو كالتجار الذين يشترون جزءً من المادة الخام أو المكررة ويوظفونها في السوق المحلية أو يصدرونها للسوق القريبة، ولا بد لهؤلاء أن يكونوا مرضيين عنهم من قبل الطبقة المسيطرة، حيث يمثلون جزءً من الحزام الاجتماعي الحامي للمشروع.
أما العمال فهم يجلبون بسبب قوة عملهم، التي يخضع تطورها لتطور قوى الإنتاج في المشروع.
إن السيطرةَ الإقطاعية تصيرُ دائماً هي مضمون الظاهرات الاقتصادية، في حين يغدو الشكلُ رأسمالياً، وهذا التناقضُ هو مشكلُ البضاعةَ الأساسية، التي هي المادة الخام الكبرى التي يقوم عليها الاقتصاد كالفوسفات أو البترول أو القطن، ومن ثم يتغلغلُ في كل ظاهرات الإنتاج والحياة.
فكما رأينا كيف غدت سلعة البترول وهي البضاعة الأساسية التي ستحركُ نظامَ الإنتاج برمتهِ متناقضةً بين سيطرة الإدارة السياسية الاستعمارية – المحلية، ذات التوجه السياسي المفروض من أعلى، وبين طبيعة السلعة ذات المعايير الاقتصادية الحديثة المجلوبة من الغرب والمعبرة عن عالم (حر)، فنرى في (البضاعة) صراع التشكيلتين وتباينهما.
فهنا إقطاع وهناك رأسمالية، هنا قديمٌ مهيمن، وهناك حديثٌ براني خارجي، وكما يبدو ذلك في السلعة التي تشكلُها قوةُ العمل فإن قوةَ العمل ذاتها تعيشُ نفس التناقض.
فقوة العمل المنضمة لأحدث نظام اقتصادي عالمي وقتذاك تكون مُخرجةً من حقولٍ خربة أو كاسدةٍ أو من مغاصاتٍ انتهى زمانها، أو من اقتصاد رعوي ضاق بأهله، أو من ريف متخلف تكنولوجياً واجتماعياً.
ومن هنا فالعاملُ وهو يبيعُ قوةَ عملهِ يبيعُها في وقتِ كساد أو أزمة أو انهيار أو ضعف، ولهذا فإن المعروضَ من قوة العمل يكون كبيراً، فتتدنى الأجورُ إلى أدنى حالاتها، في سلعةٍ هي ثمينة جداً على المستوى العالمي.
فالمجتمع المتخلف التابع لا يعرضُ سلعتيهِ: البترولَ والعمالَ، وهو في حالةِ حرية، بل في حالة تبعية، فيعرضهما بأسعار متدنية، سواءً على المستوى السياسي الذي يظهرُ في امتيازات النفط الممنوحة بشكلٍ أسطوري للشركات الأجنبية، أو في حالة أجور العمال التافهة.
ومن هنا فهو يقدمُ قوةَ العمل وهي في مجتمع تقليدي، مصنوعةً من موادِ عيشهِ البسيطة كالأرز والخبز والأسماك أو العدس والفول، أي كل المواد التي تصنعُ جسمَ العامل بأسعار متدنية جداً.
مثلما أن أماكنَ سكنهِ هي الأكواخُ والبيوتُ الكبيرة المزدحمة بالأطفال، ذات الإيجارات البسيطة، مثلما أن معرفته معدومة وعقله مشحون بالخرافات، وهو يجلبُ للاقتصاد الحديث ما تعلمهُ من عادات في أعمالٍ سابقة أو من فنون تعايشت واقتصاد مختلف، كما يجلبُ خاصةً أميتَهُ التي تكون بعيدةً جداً عن قراءة اتفاقيات النفط أو كيفية تشغيل الآلات.
وهكذا فإن العاملَ القادمَ لاقتصاد عصري يكون قادماً من اقتصاد إقطاعي ينهار، يعرضُ قوةَ عملِهِ كبضاعةٍ تشكلتْ في اقتصاد تقليدي، ومن هنا يتحدثُ هذا العامل شكلانياً، أي يصيرُ جزءً من عالم الحداثة وهو يحملُ داخلَهُ علاقات المجتمع الإقطاعي وثقافته، فيقوم بتغيير الثوب البحري أو الريفي أو البدوي، ويلبس البنطلون، الذي هو زي موحد سواء في مصر أم بريطانيا، مثلما يلبسُ القميصَ أو يضع النظارة، أو يتعلم بعض جوانب المهنة الحديثة.
وحين يرتقى أكثر يعرف بعض أسرار هذه الآلات الجديدة بعض الشيء، من تشغيل وملحقاته.
إن التناقض في البضاعة له مستوياتٌ متعددة، ففي البضاعة ذاتها كجسد مادي خالص، وهي هنا تتبدى كشكل سائل، فإنها تبقى في أرضها الذي ظهرت منه بجسدها نفسه أو بعض مشتقاته، في حين أنها تحصل لها تطورات هائلة حين ما تنتقل للعالم الآخر. ففي الإقطاع تظل مادة تشغيل لبعض المحركات أو مادة ثقيلة للشوارع، أما في الغرب المستورد فإنها تظهر بكل تركيباتها وتتشكل عليها مجموعة كبيرة من الصناعات.
وعلى مستوى آخر فإن هذه المادة حين تتحول إلى رأسمال في البلد المستخرجة منه تتحول إلى مداخيل في اقتصاد إقطاعي، أي تتجه أساساً لخدمة الطبقة الإقطاعية الحاكمة، وإداراتها وجيشها وبوليسها، والجزء الباقي يتوزع بين التجارة وقوة العمل.
أي أن المداخيل في البلد المصدر تتوجه أغلبها لعمليات اجتماعية وسياسية لا تضيفُ تراكماً نقدياً على البضاعة، بل تصبُ في جهة الاستهلاك الجماعي، خاصة مداخيل الطبقة الحاكمة، في حين إن التجارة توظف بعضه لعمليات استيرادية معاكسة لعملية التصدير، والجزء الأخير الأقل شأناً يظهر كأجور.
وفي حين تتضاءلُ رأسماليةُ البضاعة المنتجة في البلد المصدر، وتستحيل إلى علاقات إقطاعية اجتماعية وسياسية وثقافية، فإن كل ينابيع رأسمالية البضاعة تظهر حين تصل البلد المستورد، فتظهر مكونات كثيرة لها، كما تتصاعد قيمها بتحولها إلى مواد مصنعة، فتطور السوق الرأسمالية بقوة.
ويتعاكس التصدير والاستيراد حول البضاعة المركزية، وهي مركزية فقط في حياة البلد المصدر، لكونها مادة خام أولية أو شبه مصنعة تكون أقرب للمواد الزراعية منها للصناعة.
سلعة (البترول) سلعة حديثة رغم عفاريت الكيروسين والقار القديمة التي كانت تتراءى لبدو الصحراء ورغم الجمال المنبوذة التي تـُطلى بها.
فهي سلعة غربية اكتشفها وانتجها الغرب عبر شركاته، فضخم من وجودها ودورها كما يفعل تجاه البضائع العصرية المركزية، كالفوسفات والذهب والفضة وباقي المعادن.
لم يعرف العالمُ القديمُ السلعة المركزية التي تهيمن على البناء الاقتصادي هيمنةً كبيرةً بهذا الشكل، فهو يعيشُ على سلة كبيرة من البضائع، صحيح إن سلعة الذهب كانت تدوخه إلا أنها تبقى أداة نقد واكتناز.
إن تشكيلَ البضاعة المركزية في العالم الشرقي هو في حدِ ذاتهِ عمليةٌ جراحية خطيرة تـُعمل لمريض بالجوع ومصاب بكل الأمراض القديمة، لكنها عملية إعاقة أكثر منها عملية علاج، فهي فقط تشفي الطبيب الغربي من نهمه للذهب. فالبضاعة الرئيسية المركزيةُ تقودُ إلى تورم الجسم، فالمجتمع النفطي يغدو نفطياً، والمجتمع الفوسفاتي يبقى فوسفاتياً، ومجتمع الحرير يبقى حريرياً، ويسيطر الشاي على الهند وسيلان، وتبقى العديد من أقطار أمريكا اللاتينية مصابة باستفحال الموز كبضاعة، وتحاول بريطانيا أن تجعل المجتمع الصيني أفيونياً فلا تقدر وتستطيع أن تجعل المجتمع الأفغاني حشاشاً.
إن الاستعمار يركز على إنتاجِ سلعةٍ واحدة كبرى في البلد المعني، مثلما يقوم في المصنع بتخصيصِ أصبع واحدة للعامل من أجل العمل تاركاً كل جسده الباقي معطلاً، وكما أنه يجعل العامل معاقاً في مصنعه فإنه يجعل شعوباً كثيرة معاقة عن المشي التاريخي الطبيعي.
وفي حين إن بضاعة الشاي الهندية تظهر كجزء طبيعي من الزراعة الهندية، مثل الموز في أمريكا الوسطى، لأنها تظهر في شبكة من البضائع القديمة المختلفة، الناتجة من كيان زراعي ومدني له تاريخ هام، إلا أن بضاعة البترول مختلفة فهي تظهر فجأة من باطن الأرض المجدبة وحولها قفار وصحارى واسعة، ومن هنا كان ظهورها وتفجرها يُربط بشكل سحري وأنه جزء من نشاط الجن.
لقد ظهرت عبر استكشاف غربي، علمي، فهي بضاعةٌ لها علاقة بتطور المحركات والطاقة، وبالبحث الغربي عن مصادرٍ لطاقةِ المصانع والآلات الضامئة أبداً للنار، وجاء هذا النشاط الاستكشافي ككل حركة علمية مرتبطاً بالحاجة الضرورية لقوى الإنتاج، وفي هذا الوقت كان التفسخ يتوالى على الأمبراطورية العثمانية آخر أمبراطورية جمعت المسلمين، فكان تفكيك هذه الأمبراطورية يتناغم مع انفتاح شهية الدول الغربية للاستعمار، ومع ظمأ المصانع لطاقة رخيصة كبيرة، فاشتغلت اليدان السياسية والعلمية على تقديم البلدان شبه الصحراوية و الصحراوية كبضاعة سياسية كبيرة على مائدة جوع العواصم الغربية وآلاتها.
وهكذا أختلفت بضاعة البترول عن بضاعة الشاي الهندي، فهي بضاعة مرمية في الصحراء البعيدة، لا تربطها وشائج بالمدن، وهناك شيوخ القبائل يمرون ويتغوطون دون أن يعبأوا بهذه الرمال الخالية.
فليس ثمة شبكة تربطها بمدن أو بزراعة، وليس ثمة أحد يملكها، فهي (معجزة).
September 28, 2021
عبÙÙÙÙÙÙÙداÙÙÙ Ø®ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙØ© : Ø´Ùرا٠ÙÙÙ WordPress ÙØ°Ùر٠7 سÙÙات رائعة ٠٠اÙ٠تعة ÙÙÙÙراء ÙØ´Ùر سبت٠بر ÙÙ Ùذ٠اÙدÙÙ:

Ø´Ùرا٠ÙÙÙ WordPress ÙØ°Ùر٠7 سÙÙات رائعة Ù
٠اÙÙ
تعة ÙÙÙÙراء ÙØ´Ùر سبتÙ
بر ÙÙ Ùذ٠اÙدÙÙ:
â ÙÙدا
â إسباÙÙا
â اÙÙ
غرب
â اÙÙÙاÙات اÙÙ
تØدة
â Ø£ÙÙ
اÙÙا
â Ø£ÙرÙÙدا
â ترÙÙا
â اÙعراÙ
â اÙØ¥Ù
ارات اÙعربÙØ© اÙÙ
تØدة
â اÙأردÙ
â اÙÙÙ
سا
â اÙجزائر
â اÙÙÙÙت
â Ùطر
â اÙاتØاد اÙأرÙبÙ
â جÙÙب Ø£ÙرÙÙÙا
â اÙسÙغاÙ
â اÙÙ
Ù
ÙÙØ© اÙعربÙØ© اÙسعÙدÙØ©
â Ù
صر
â ÙÙجÙرÙا
â اÙÙÙد
â تÙÙس
â اÙسÙداÙ
â ÙÙبÙا
â بÙÙÙدا
â ÙÙسطÙÙ
â ÙرÙسا
â عÙÙ
اÙ
â سÙرÙا
â Ø¥ÙراÙ
â اÙÙÙ
Ù
â اÙبØرÙÙ
عبـــــــدالله خلــــــــيفة : شكراً لــ WordPress لذكرى 7 سنوات رائعة من المتعة وللقراء لشهر سبتمبر في هذه الدول:

شكراً لــ WordPress لذكرى 7 سنوات رائعة من المتعة وللقراء لشهر سبتمبر في هذه الدول:
⊛ كندا
⊛ إسبانيا
⊛ المغرب
⊛ الولايات المتحدة
⊛ ألمانيا
⊛ أيرلندا
⊛ تركيا
⊛ العراق
⊛ الإمارات العربية المتحدة
⊛ الأردن
⊛ النمسا
⊛ الجزائر
⊛ الكويت
⊛ قطر
⊛ الاتحاد الأروبي
⊛ جنوب أفريقيا
⊛ السنغال
⊛ المملكة العربية السعودية
⊛ مصر
⊛ نيجيريا
⊛ الهند
⊛ تونس
⊛ السودان
⊛ ليبيا
⊛ بولندا
⊛ فلسطين
⊛ فرنسا
⊛ عُمان
⊛ سوريا
⊛ إيران
⊛ اليمن
⊛ البحرين
عبÙÙÙÙÙÙÙداÙÙÙ Ø®ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙØ© : رسائ٠ج٠ا٠عبداÙÙاصر اÙسرÙØ©
عÙ٠اÙرابط https://www.instagram.com/p/CUX2o-Ujexs/?utm_medium=copy_link
عبـــــــدالله خلــــــــيفة : رسائل جمال عبدالناصر السرية
September 26, 2021
عبÙÙÙÙÙÙÙداÙÙÙ Ø®ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙØ© : اÙر٠Ùز٠اÙدÙÙÙØ©Ù ÙاÙأساطÙر
تأخذ اÙØ«ÙاÙة٠اÙشعبÙØ© اÙدÙÙÙØ© اÙإسÙا٠Ùة٠اÙراÙÙØ© اÙتارÙخ٠اÙ٠اض٠٠٠خÙاÙÙ Ù Ùظار اÙأساطÙر اÙÙÙÙ ÙØ©.
اÙأساطÙر٠اÙÙÙÙ ÙØ©Ù ÙÙÙس اÙعÙÙاÙÙØ© اÙÙÙÙ ÙØ© سÙاء٠ÙاÙت عربÙØ© Ø£Ù ÙارسÙØ© أ٠ترÙÙØ© Ø£Ù ÙÙدÙØ© ÙغÙرÙØ§Ø Ù Ø±ØÙة٠٠٠تÙÙÙ٠اÙÙÙÙ Ùات اÙإسÙا٠ÙØ© اÙ٠ختÙÙØ© Ù٠ظÙ٠اÙØ«ÙاÙة٠اÙسØرÙØ© ÙاÙدÙÙÙØ©Ø ØÙÙ ÙÙÙ٠٠جÙاز٠ØÙÙ٠٠٠سÙطر٠٠رÙز٠Ùا٠ع بدÙس٠أØÙا٠اÙشعÙب ÙرÙض تجÙÙاتÙا اÙØرة Ù٠٠جا٠اÙسÙاسة ÙاÙØÙÙÙ ÙتختÙ٠أساطÙرÙا ÙتارÙØ®Ùا اÙخاص Ù٠ظ٠اÙØ«ÙاÙØ© اÙدÙÙÙØ© اÙتÙØÙدÙØ© اÙعا٠ة.
أراد اÙعرب٠اÙتÙØÙدÙÙ٠اÙÙÙØ¶Ø©Ø ÙÙ٠اÙ٠رØÙØ© اÙراشدÙØ© اÙÙØ§Ù Ø¶Ø©Ø Ø´ÙÙÙا بعض اÙظرÙ٠اÙÙ ÙÙدة بÙ٠اÙØÙا٠ÙاÙÙ ØÙÙÙ ÙÙØ ÙاÙت رؤاÙ٠اÙدÙÙÙØ© ÙظرÙÙÙ٠تشÙÙÙ Ø°Ù٠اÙتÙÙج٠اÙØ¥ÙساÙ٠اÙÙØ§Ø¯Ø±Ø ÙÙ٠٠رØÙØ© اÙت٠دد اÙÙ ÙاطÙ٠اÙÙاسع ÙاÙÙتÙØØ§ØªØ Ø¹Ø§Ø¯ØªÙ Ø¨Ø¸Ø±Ù٠٠ختÙÙØ©.
Ùشأت Ùئات٠أÙثر٠غÙ٠أÙضÙÙت٠ÙÙÙئات٠اÙغÙÙØ© اÙتÙÙÙدÙØ© اÙت٠ÙاÙت تÙÙ٠بذÙ٠عبر ÙرÙÙ.
بÙ٠أ٠ÙØ© خاصة Ø£Ùثر اÙØ°Ù٠إستÙادÙا ٠٠اÙ٠رØÙتÙÙØ ÙأصطÙت٠إÙ٠جاÙبÙÙÙ Ùئات٠عدÙدة٠٠٠ÙرÙØ´ ÙاÙاÙصار ÙاÙÙاتØÙÙØ ÙÙÙØ«Ùرت اÙثرÙØ§ØªØ Ù٠ا عاد ÙÙج٠اÙ٠ساÙاة اÙساب٠بÙادر٠عÙ٠اÙص٠Ùد أ٠ا٠اÙت٠اÙزات اÙاجت٠اعÙØ© اÙØادة.
Ùا٠صعÙد٠بÙ٠أ٠ÙØ© ث٠رة طبÙÙعة ÙÙÙ Ùذ٠اÙتØÙÙØ§ØªØ ÙÙا٠ثرÙاتÙ٠اÙتارÙØ®ÙØ© اÙسابÙØ©Ø Ø¥Ø¶Ø§ÙØ© ÙÙثرÙات اÙت٠إÙÙاÙت عÙÙÙ٠بعد اÙÙتÙØØ§ØªØ Ùد ÙÙÙÙت٠ÙÙادر٠سÙاسÙØ©Ù ÙعسÙرÙØ© ٠جربة ÙÙ Ùستطع بÙÙ Ùاش٠٠جاراتÙÙ ÙÙ Ùذ٠اÙأعداد.
Ùإستث٠رت بÙ٠أ٠ÙØ© Ùذ٠اÙÙدرات ÙعرÙت ÙÙ٠تÙÙ٠اÙتØاÙÙات ٠ع اÙÙÙ٠اÙغÙÙØ© اÙصاعدة ÙÙ ÙرÙØ´ ÙÙ٠اÙØ£ÙØµØ§Ø±Ø Ùإست٠اÙت دÙاة اÙعرب اÙ٠عرÙÙÙÙ.
ÙÙا تÙجد٠ÙÙا ٠ؤا٠رة٠٠ØبÙÙØ©Ù Ù ÙØ° Ùجر اÙتارÙØ® اÙإسÙا٠٠عÙ٠بÙÙ ÙØ§Ø´Ù Ø Ø¨Ù Ù٠اÙصراعات٠اÙاجت٠اعÙØ© ÙاÙسÙاسÙØ© اÙطبÙعÙØ©Ø ÙصعÙد ÙÙ Ùذج اÙÙا٠ساÙØ§Ø©Ø ÙØرÙب اÙÙتÙØات اÙت٠ÙÙÙت Ùئات ÙبÙرة ٠٠اÙأغÙÙاء تØاÙÙت ÙÙÙÙت طبÙØ© عربÙØ© بدÙÙØ© Ù٠ز٠٠اÙØ£Ù ÙÙÙÙ ÙعربÙØ© ÙارسÙØ© ٠تØضرة Ù٠ز٠٠اÙعباسÙÙÙ.
ÙبÙذا Ùإ٠بÙ٠أ٠ÙØ© ج٠عت٠خÙÙط٠اÙسÙطا٠بÙÙ ÙدÙÙا ÙØ£ÙÙا إستث٠رت٠اÙتØÙÙØ§ØªØ ÙÙ٠أ٠ر٠عارضتÙÙ ÙÙÙ ÙØ«ÙØ±Ø©Ø Ø¹Ø±Ø¨ÙØ© ÙغÙر عربÙØ©Ø ÙÙÙ Ù٠تستطع تÙÙÙ٠دÙÙØ© اÙ٠ساÙاة اÙشعبÙØ© اÙت٠اØتاجت ظرÙÙا٠سÙاسÙØ© ÙÙÙرÙØ© ÙبÙرة ÙاÙتشار اÙدÙÙ ÙراطÙØ© Ù٠عرÙØ© ظرÙ٠اÙاÙتخابات ÙاÙتØاÙ٠بÙ٠اÙÙخب اÙØ·ÙÙعÙØ© اÙتجارÙØ© ÙاÙÙ Ø«ÙÙØ© ÙÙØ°Ù ÙÙÙا تØتاج Ùعصر ٠ختÙÙ Ù٠ا Ùبدأ Ø°ÙÙ Ù٠عصرÙا اÙراÙ٠اÙذ٠تتÙÙر ÙÙ٠بعض Ùذ٠اÙشرÙØ· اÙÙبÙرة.
ÙÙ Ùذج٠اÙ٠ساÙاة دائ٠ا٠ÙÙ ÙÙ Ùذج Ø£ÙÙ٠تأسÙس٠تج٠ÙعÙØ ÙÙ٠ظرÙ٠اÙتارÙØ® اÙطبÙÙ Ù٠٠ختÙÙØ©Ù ÙÙ٠تÙرس٠اÙÙا٠ساÙاة ÙظÙÙر اÙت٠اÙزات اÙÙبÙÙØ© ÙاÙÙÙÙ ÙØ© ÙاÙسÙاسÙØ© Øت٠تظÙر ظرÙÙ٠٠عاصرة تخÙÙÙ Ù ÙÙا ث٠تÙÙÙÙا. ÙتتÙØ Ø§Ùرأس٠اÙÙØ© اÙØدÙثة Ø°Ù٠عبر ظÙÙر اÙطبÙتÙ٠اÙ٠تصارعتÙ٠اÙ٠تØاÙÙتÙÙ Ù٠اÙبÙاء اÙدÙÙ ÙراطÙ: اÙبرجÙازÙØ© ÙاÙع٠اÙ.
ÙÙÙ Ùذج اÙÙا٠ساÙاة اÙØ£Ù Ù٠جع٠اÙشعÙب اÙÙ ÙغزÙÙØ© Ù Ù Ùب٠اÙعرب اÙ٠سÙÙ Ù٠تثÙر٠ÙØªØ±ØªØ¯Ø ÙتÙÙÙ٠تارÙخ٠اÙ٠ذاÙب اÙ٠ختÙÙØ© ٠ع Ù Ø°Ùب اÙعاص٠ة اÙØاÙÙ Ø©.
ÙتتصÙر اÙصراعات اÙاجت٠اعÙØ© اÙطبÙعÙØ© ٠ؤا٠رات Ù Ù Ùب٠اÙØ£Ù ÙÙÙÙ ÙÙ Ù Ùب٠اÙعرب ÙÙ Ù Ùب٠اÙسÙØ© ÙاÙØ´Ùعة ÙبÙÙØ© اÙØ·Ùائ٠ÙÙ٠صراعات إجت٠اعÙØ©.
ÙÙÙ Ø®Ùا٠Ùذا اÙÙزاع اÙاجت٠اع٠(اÙÙÙÙ Ù) Ùشأت٠أساطÙر٠اÙ٠ذاÙب٠ÙتصÙÙر٠اÙتارÙØ® ب٠ا ÙÙس ÙÙÙØ ÙإضÙاء اÙصراعات اÙشعÙبÙØ© عÙ٠اÙتارÙØ® اÙدÙÙÙ. ÙتÙجÙر اÙØ®ÙاÙات ÙÙ Ùع اÙتطÙرات ÙÙ Ù٠دÙÙØ© ÙعÙ٠٠ستÙ٠اÙأ٠٠اÙإسÙا٠ÙØ© اÙ٠ختÙÙØ©.
Ùرع٠٠رÙر ÙÙ Ùذ٠اÙÙرÙÙ ÙÙ٠اÙعÙÙÙØ© اÙت٠زÙÙÙØ© غÙر اÙتÙØÙدÙØ© ٠ازاÙت تÙعÙÙ ÙعÙÙØ§Ø Ùتضع٠اÙ٠ؤا٠رة٠اÙÙا٠Ùة٠اÙشرÙØ±Ø©Ø Ùر٠زÙا أبÙÙØ³Ø Ù٠اÙتارÙØ® اÙبشر٠اÙاجت٠اع٠اÙÙ ØØ¶Ø ÙتعÙد ÙÙÙ Ø´ÙØ¡ ÙÙØ®Ùار٠ÙاÙغÙبÙات.
ÙÙÙ ÙÙ ÙÙا تصÙÙر ÙرÙÙ٠اÙصØابة عبر اÙعÙاÙات بÙ٠اÙÙائÙات اÙØ®Ùرة أ٠اÙشرÙرة Øسب Ù ÙÙع اÙÙ ÙصÙر٠ÙاÙÙØ§ØªØ¨Ø ÙÙ ØÙ٠أ٠اÙتارÙخ٠Ù٠أسبابÙ٠اÙÙاÙعÙØ© اÙ٠ختÙÙØ©Ø ÙÙ٠صراع٠اÙعرب ÙاÙÙرس٠ÙاÙأترا٠ÙاÙÙÙÙØ¯Ø ØµØ±Ø§Ø¹Ù Ø§ÙأغÙÙاء٠ÙاÙÙÙØ±Ø§Ø¡Ø ØµØ±Ø§Ø¹Ù Ø§ÙØÙا٠٠ÙاÙÙ ØÙÙÙ ÙÙØ ØµØ±Ø§Ø¹Ù Ø§Ù٠رÙز٠اÙ٠سÙطر ÙاÙأطرا٠اÙÙ ØÙÙÙ Ø©Ø ØµØ±Ø§Ø¹ اÙÙÙÙ Ùات اÙ٠تÙارÙØ© ÙÙتذاÙ.
Ùذ٠اÙإسÙاطات٠عÙ٠اÙتارÙخ٠اÙإسÙا٠٠اÙ٠بÙر ت٠ثÙ٠تارÙØ®Ùة٠اÙØ«ÙاÙØ© Ùد٠اÙشعÙب اÙإسÙا٠ÙØ© ÙÙ٠تÙÙÙÙÙ ÙÙسÙÙا داخ٠عباءة Ùذ٠اÙØ«ÙاÙØ© ÙÙÙ Ù Ù Ø®Ùا٠اÙÙ ÙÙع اÙ٠ختÙÙ.
ÙØÙ٠تÙتÙ٠أسباب٠اÙصراع بÙ٠اÙعرب ÙاÙÙرس ÙاÙأترا٠ÙغÙرÙ٠٠٠اÙشعÙب اÙإسÙا٠ÙØ©Ø ØªØªØ¶Ø§Ø¡ÙÙ Ùذ٠اÙÙصص٠اÙÙ ÙÙÙÙÙة٠داخ٠اÙÙ ÙØ«ÙÙÙجÙا اÙشعبÙØ©Ø ÙاÙت٠ÙÙترض٠أ٠ترتÙع٠عÙÙا اÙÙخب٠ÙاÙÙادة اÙسÙاسÙÙÙØ ÙÙؤسسÙا عÙاÙات ٠ختÙÙØ© بÙ٠اÙأ٠٠اÙإسÙا٠ÙØ©Ø ÙÙصÙعÙا تارÙخا٠٠ختÙÙاÙ.
ÙÙ٠بÙاء Ùذ٠اÙÙصص Ùعبر٠ع٠إست٠رار اÙعÙاÙات غÙر اÙدÙÙ ÙراطÙØ© اÙتØدÙØ«ÙØ© بÙ٠اÙÙخب ÙاÙشعÙØ¨Ø Ùضخا٠ة اÙÙ ÙرÙØ« ÙاÙعÙاÙات اÙعÙÙÙØ© ÙاÙÙراÙÙØ© بÙ٠بعض اÙشعÙب اÙإسÙا٠ÙØ© اÙ٠تجاÙØ±Ø©Ø ÙÙØ°Ù٠ع٠عد٠Ùدرة اÙÙخب بÙدراتÙÙا اÙØاÙÙØ© عÙ٠إعادة تØدÙØ« اÙشعÙب اÙإسÙا٠ÙØ© اÙعائشة ÙÙ ÙÙاÙ٠تÙÙÙدÙØ© ٠تخÙÙØ©.
عبـــــــدالله خلــــــــيفة : الرموزُ الدينيةُ والأساطير
تأخذ الثقافةُ الشعبية الدينية الإسلاميةُ الراهنة التاريخَ الماضي من خلالِ منظار الأساطير القومية.
الأساطيرُ القوميةُ وليس العقلانية القومية سواءً كانت عربية أم فارسية أم تركية أم هندية وغيرها، مرحلةٌ من تكونِ القوميات الإسلامية المختلفة في ظلِ الثقافةِ السحرية والدينية، حين يقومُ جهازٌ حكومي مسيطرٌ مركزي قامع بدهسِ أحلام الشعوب ورفض تجلياتها الحرة في مجال السياسة والحقوق فتختلق أساطيرها وتاريخها الخاص في ظل الثقافة الدينية التوحيدية العامة.
أراد العربُ التوحيديون النهضة، وفي المرحلة الراشدية الوامضة، شكلوا بعض الظروف المفيدة بين الحكام والمحكومين، كانت رؤاهم الدينية وظروفهم تشكلُ ذلك التوهجَ الإنساني النادر، لكن مرحلة التمدد المناطقي الواسع والفتوحات، عادتْ بظروف مختلفة.
نشأت فئاتٌ أكثرُ غنى أُضيفتْ للفئاتِ الغنية التقليدية التي كانت تقوم بذلك عبر قرون.
بني أمية خاصة أكثر الذين إستفادوا من المرحلتين، وأصطفتْ إلى جانبِهم فئاتٌ عديدةٌ من قريش والانصار والفاتحين، وكَثُرت الثروات، وما عاد نهجُ المساواة السابق بقادرٍ على الصمود أمام التمايزات الاجتماعية الحادة.
كان صعودُ بني أمية ثمرة طبييعة لكل هذه التحولات، وكان ثرواتهم التاريخية السابقة، إضافة للثروات التي إنهالت عليهم بعد الفتوحات، قد كوّنتْ كوادرَ سياسيةً وعسكرية مجربة لم يستطع بنو هاشم مجاراتهم في هذه الأعداد.
وإستثمرت بني أمية هذه القدرات وعرفت كيف تقيم التحالفات مع القوى الغنية الصاعدة في قريش وفي الأنصار، وإستمالت دهاة العرب المعروفين.
فلا توجدُ هنا مؤامرةٌ محبوكةٌ منذ فجر التاريخ الإسلامي على بني هاشم، بل هي الصراعاتُ الاجتماعية والسياسية الطبيعية، وصعود نموذج اللامساواة، وحروب الفتوحات التي كونت فئات كبيرة من الأغنياء تحالفت وكونت طبقة عربية بدوية في زمن الأمويين وعربية فارسية متحضرة في زمن العباسيين.
وبهذا فإن بني أمية جمعتْ خيوطَ السلطان بين يديها لأنها إستثمرتْ التحولات، وهو أمرٌ عارضتهُ قوى كثيرة، عربية وغير عربية، لكن لم تستطع تكوين دولة المساواة الشعبية التي احتاجت ظروفاً سياسية وفكرية كبيرة كانتشار الديمقراطية ومعرفة ظروف الانتخابات والتحالف بين النخب الطليعية التجارية والمثقفة وهذه كلها تحتاج لعصر مختلف كما يبدأ ذلك في عصرنا الراهن الذي تتوفر فيه بعض هذه الشروط الكبيرة.
نموذجُ المساواة دائماً هو نموذج أولي تأسيسي تجميعي، لكن ظروف التاريخ الطبقي هي مختلفةٌ وهي تكرسُ اللامساواة وظهور التمايزات القبلية والقومية والسياسية حتى تظهر ظروفٌ معاصرة تخففُ منها ثم تنفيها. وتتيح الرأسمالية الحديثة ذلك عبر ظهور الطبقتين المتصارعتين المتحالفتين في البناء الديمقراطي: البرجوازية والعمال.
ونموذج اللامساواة الأموي جعل الشعوب المَغزُوة من قبل العرب المسلمين تثورُ وترتد، وتكونُ تاريخَ المذاهب المختلفة مع مذهب العاصمة الحاكمة.
وتتصور الصراعات الاجتماعية الطبيعية مؤامرات من قبل الأمويين ومن قبل العرب ومن قبل السنة والشيعة وبقية الطوائف وهي صراعات إجتماعية.
وفي خلال هذا النزاع الاجتماعي (القومي) نشأتْ أساطيرُ المذاهبِ وتصويرُ التاريخ بما ليس فيه، وإضفاء الصراعات الشعوبية على التاريخ الديني. وتفجير الخلافات ومنع التطورات في كل دولة وعلى مستوى الأمم الإسلامية المختلفة.
ورعم مرور كل هذه القرون لكن العقلية التمزيقية غير التوحيدية مازالت تفعلُ فعلها، وتضعُ المؤامرةَ الكامنةَ الشريرة، ورمزها أبليس، في التاريخ البشري الاجتماعي المحض، فتعيد كلَ شيء للخوارق والغيبيات.
ويمكن هنا تصوير فريقي الصحابة عبر العلاقات بين الكائنات الخيرة أو الشريرة حسب موقع المُصورِ والكاتب، في حين أن التاريخَ له أسبابهُ الواقعية المختلفة، وهو صراعُ العرب والفرسِ والأتراك والهنود، صراعُ الأغنياءِ والفقراء، صراعُ الحكامِ والمحكومين، صراعُ المركزِ المسيطر والأطراف المحكومة، صراع القوميات المتوارية وقتذاك.
هذه الإسقاطاتُ على التاريخِ الإسلامي المبكر تمثلُ تاريخيةَ الثقافة لدى الشعوب الإسلامية وهي تكّونُ نفسَها داخل عباءة هذه الثقافة لكن من خلال الموقع المختلف.
وحين تنتفي أسبابُ الصراع بين العرب والفرس والأتراك وغيرهم من الشعوب الإسلامية، تتضاءلُ هذه القصصُ المكَّونةُ داخل الميثولوجيا الشعبية، والتي يفترضُ أن ترتفعَ عنها النخبُ والقادة السياسيون، ويؤسسوا علاقات مختلفة بين الأمم الإسلامية، ويصنعوا تاريخاً مختلفاً.
لكن بقاء هذه القصص يعبرُ عن إستمرار العلاقات غير الديمقراطية التحديثية بين النخب والشعوب، وضخامة الموروث والعلاقات العنفية والكراهية بين بعض الشعوب الإسلامية المتجاورة، وكذلك عن عدم قدرة النخب بقدراتِها الحالية على إعادة تحديث الشعوب الإسلامية العائشة في هياكل تقليدية متخلفة.
__ATA.cmd.push(function() { __ATA.initDynamicSlot({ id: 'atatags-26942-6150b7c416482', location: 120, formFactor: '001', label: { text: 'الإعلانات', }, creative: { reportAd: { text: 'الإبلاغ عن هذا الإعلان', }, privacySettings: { text: 'الخصوصية', } } }); });September 16, 2021
عبÙÙÙÙÙÙÙداÙÙÙ Ø®ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙØ© : تجارب رÙائÙØ© ÙÙصصÙØ© ٠٠اÙØ®ÙÙج ÙاÙجزÙرة اÙعربÙØ©
Ùذا اÙÙتاب سÙÙشر Ùا٠Ùا٠ÙÙ Ù ÙÙع : عبÙÙÙÙÙÙÙداÙÙÙ Ø®ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙØ© Ùاتب ÙرÙائ٠بتارÙØ® 21/10/2021.
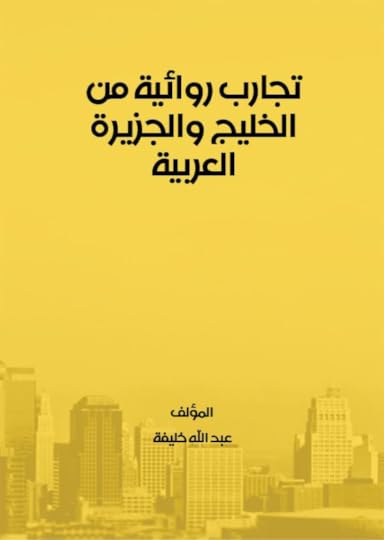
â تÙطئة.
â ٠سارات رÙائÙØ©.
â اÙ٠ع٠ار اÙرÙائ٠Ù٠اÙØ®ÙÙج ÙاÙجزÙرة اÙعربÙØ© بÙ٠اÙØ°Ùبا٠ÙاÙتشÙÙ.
â بÙ٠اÙÙص ÙاÙرÙاÙØ©: « ÙÙÙاء تعتر٠ÙÙ٠» ÙÙ Ø®ÙÙØ© اÙÙزÙÙÙÙ.
â بÙ٠اÙÙص ÙاÙرÙاÙØ©: «عاÙ٠اÙØرÙر» ÙÙ٠رجاء عاÙÙ .
â بÙ٠اÙÙص ÙاÙرÙاÙØ©: «اÙÙÙاخذة» ÙÙ ÙÙزÙØ© Ø´ÙÙØ´ اÙساÙÙ .
â بÙ٠اÙÙص ÙاÙرÙاÙØ©: «اÙعصÙÙرÙة» Ù٠غاز٠اÙÙصÙبÙ.
â بÙ٠اÙÙص ÙاÙرÙاÙØ©: «جرÙØ Ø§ÙذاÙرة» Ù٠ترÙ٠اÙØ٠د.
â ثاÙÙاÙØ Ø§ÙرÙاÙØ© تتÙÙÙ: «اÙÙائ٠اÙظÙ» ÙÙ٠إس٠اعÙÙ ÙÙد إس٠اعÙÙ.
â اÙرÙاÙØ© تتÙÙÙ: «ÙÙÙØ© اÙØب» ÙÙ Ù Ø٠د عبداÙÙ ÙÙ.
â اÙرÙاÙØ© تتÙÙÙ: «Øارس اÙØ£ÙÙا٠اÙر٠ادÙة» ÙÙ٠ج٠ا٠اÙØ®Ùاط.
â اÙرÙاÙØ© تتÙÙÙ: «اÙØ·ÙÙ» Ù٠عبد٠خاÙ.
â اÙرÙاÙØ© تتÙÙÙ: «اÙبرزخ» ÙÙ ÙرÙد ر٠ضاÙ.
â رÙاÙØ© تتÙÙÙ: «اÙÙÙ٠اÙسرÙ» ÙÙ ÙÙزÙØ© رشÙد.
â رÙاÙØ© تتÙÙÙ: «Ùخاخ اÙرائØة» ÙÙ ÙÙس٠اÙÙ ØÙÙ Ùد.
â رÙاÙØ© تتÙÙÙ: «Ù٠٠رÙ٠» Ù٠عبداÙÙادر عÙÙÙ.
â خات٠ة : Ù Ø´Ùد عا٠.
â رÙاÙØ© اÙشباب Ù٠اÙØ®ÙÙج ÙاÙجزÙرة اÙعربÙØ©.
â «٠Ùا٠ات» Ù٠جÙخة اÙØارثÙ.
â «اÙØزا٠» ÙØ£Ø٠د أب٠دÙ٠اÙ.
â «صÙÙÙا» ÙÙ Ù Ø٠د Øس٠عÙÙاÙ.
â «اÙجسد اÙراØÙ» Ùأس٠اء اÙزرعÙÙÙ.
â «أÙ.. عÙ٠٠ر٠٠صØراء.. Ù٠اÙØ®ÙÙ» Ù٠عÙاض شاÙر اÙعصÙÙ Ù.
â «بØرÙات» Ø£Ù ÙÙ Ø© اÙخ٠Ùس.
â «جاÙÙÙة» ÙÙÙ٠اÙجÙÙÙ.
â «طÙÙÙ» سÙ٠اÙإسÙا٠ب٠سعÙد.
â «تÙر٠٠بشررÙ» عبد٠خاÙ.
â «رÙØ Ø§ÙجÙة» Ù٠ترÙ٠اÙØ٠د.
â «بÙات اÙرÙاض» ÙÙست رÙاÙØ© ÙضائØ.
â «زرÙاب» ÙÙ Ù ÙبÙ٠اÙعÙÙÙ.
â خات٠ة.
â ٠٠اÙتجربة اÙرÙائÙØ© Ù٠دÙÙØ© اÙإ٠ارات اÙعربÙØ©.
â «شاÙÙدة» Ù٠راشد عبداÙÙÙ.
â «ساØ٠اÙأبطاÙ» Ù٠عÙ٠راشد Ù Ø٠د.
â «أØداث ٠دÙÙØ© عÙ٠اÙشاطئ» ÙÙ Ù Ø٠د Øس٠اÙØربÙ.
â «اÙاعتراÙ» Ù٠عÙ٠أبÙاÙرÙØ´.
â استÙتاجات.
â اÙسرد اÙرÙائ٠Ù٠تجربة ج٠ا٠اÙØ®Ùاط.
â تÙطئة.
â اÙÙصة اÙعائÙÙØ© اÙÙ Ùسعة.
â است٠رارÙØ© اÙÙص اÙØ·ÙÙÙ.
â اÙتØÙ٠إÙ٠اÙرÙاÙØ©.
â بذرة٠٠ÙØÙ Ø©Ù ÙØ·ÙÙØ©.
â اÙØ´ÙÙ٠اÙرÙائÙÙ٠اÙÙ ÙتÙØ Ùتجربة غاز٠اÙÙصÙبÙ.
â بداÙØ© غاز٠اÙÙصÙبÙ.
â اÙتجربة اÙرÙائÙØ©.
â «أبÙØ´Ùاخ اÙبر٠ائÙ».
â رÙاÙØ© «سبعة».
â رÙاÙØ© «اÙجÙÙة».
â اÙØ«Ùرة اÙÙØ·ÙÙØ© Ù٠اÙرÙاÙØ© اÙعربÙØ© Ù٠اÙØ®ÙÙج.
â تÙطئة.
â تجربة عبداÙرØÙ Ù Ù ÙÙÙ ÙÙ ÙذجاÙ.
â «أرض٠اÙسÙاد» إشÙاÙÙØ© اÙتأÙÙÙ.
â «أرض٠اÙسÙاد» ÙأساسÙات «٠د٠اÙÙ ÙØ».
â «أرض اÙسÙاد» بÙÙØ© عا٠ة.
â «أرض اÙسÙاد» تÙاثر اÙشخصÙات.
â «أرض اÙسÙاد» اÙتÙÙÙات اÙرÙائÙØ©.
â Ùع٠Ù٠ا٠Ùا تÙجد تÙÙÙات جدÙدة Ù ÙÙتة Ù٠اÙرÙاÙØ©.
â «أرض اÙسÙاد» اÙدÙاÙات اÙسÙاسÙØ©.
â تجارب ÙصصÙØ© ٠٠اÙØ®ÙÙج ÙاÙجزÙرة اÙعربÙØ©.
â تØÙÙات اÙÙصة اÙÙصÙرة اÙبØرÙÙÙØ©.
â اÙÙصة اÙÙصÙرة عبر Ù Ùجة اÙسبعÙÙÙات.
â Ùتابة اÙشباب اÙÙصصÙØ©.
â Øس٠بÙØسÙ.
â جعÙر Ø£ÙÙ Ù ÙÙسÙ.
â ٠عصÙÙ Ø© اÙ٠طاÙعة.
â سعاد Ø¢Ù Ø®ÙÙÙØ©.
â Ø£Ø٠د اÙ٠ؤذÙ.
â Ù٠اذج ٠٠اÙÙصة٠اÙÙصÙرة٠باÙÙ Ù ÙÙØ© اÙعربÙØ© اÙسعÙدÙØ©.
â ÙÙ Øات٠٠٠أع٠اÙ٠رÙاد.
â ÙÙد اÙعتÙÙ.
â إبراÙÙ٠اÙÙÙ ÙØ©.
â جاراÙÙ٠اÙØÙ Ùد.
â عبداÙعزÙز ٠شرÙ.
â Ù Ø٠د اÙÙ ÙصÙر اÙØ´ÙØاء.
â Ø£Ù ÙÙ Ø© بÙت Ù ÙÙر اÙبدرÙ.
â شرÙÙØ© اÙØ´Ù ÙاÙ.
â اÙخات٠ة.
â تجربة ÙصصÙØ© ٠٠اÙإ٠ارات .
â سÙ٠٠٠طر سÙÙ .
â Ù ÙØÙÙÙÙÙÙÙÙ:
â تطÙر اÙÙصة اÙÙصÙرة ÙعÙاÙت٠باÙتطÙر اÙاجت٠اع٠Ù٠اÙبØرÙÙ.
â اÙ٠رأة Ù٠اÙÙصة اÙبØرÙÙÙØ©.
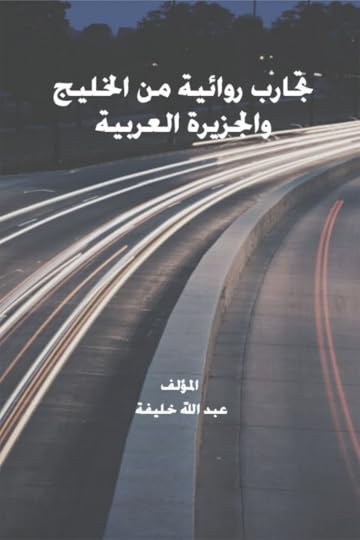
Ùذا اÙÙتاب سÙÙشر Ùا٠Ùا٠ÙÙ Ù ÙÙع : عبÙÙÙÙÙÙÙداÙÙÙ Ø®ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙØ© Ùاتب ÙرÙائ٠بتارÙØ® 21/10/2021.




