محمد إلهامي's Blog, page 47
April 21, 2016
تبسيط تاريخ مصر الحديث (3)
كاتب مشارك: د. عمرو عادل
اقرأ أولا: تبسيط تاريخ مصر الحديث (1) تبسيط تاريخ مصر الحديث (2)
(9)ثورة 25 يناير
شاخ نظام يوليو وبدت آثاره السلبية مع الشيخوخة الطويلة لحسني مبارك (ثمانون عاما)، وصارت مصر مرتعا للفساد، وقد اجتمعت عوامل إزالة نظام مبارك وإن لم تجتمع عوامل حدوث ثورة. على هذا النحو الآتي:
1. ظل السلاح محتكرا بيد السلطة، الجيش والأجهزة الأمنية، ومن فوقهما القوة الخارجية (أمريكا) صاحبة النفوذ الفعلي الأكبر على الساحة المصرية. وقد التقت الرغبة الأمريكية مع رغبة الجيش في إزاحة نظام مبارك. أما الجيش فلأنه لا يؤيد انتقال السلطة لمدني (جمال مبارك الغلام الصغير معدوم المواهب)، وأما أمريكا فلظنها أنها تستطيع إقامة حكم ديمقراطي في مصر يجنبها مشكلة الإرهاب ويحتوي التيارات الإسلامية فيدجنها ويخضعها لمنظومة الديمقراطية. فلما اجتمعت هاتان الرغبتان، حسم أمر نظام مبارك وجرى انقلاب عسكري –متقنع بقناع الثورة وإرادة الشعب- عليه في 11 فبراير.
2. شهد الوعي طفرة كبرى في السنوات الست الأخيرة من حكم مبارك، وذلك لأكثر من سبب أهمها: (أ) الانترنت الذي مثل كسرا لاحتكار المعلومة وبيئة للمقاومة والتقاء الشباب وأفكارهم الثورية وسبل تطبيقها عمليا. (ب) الإعلام الذي شهد موجة حرية غير مسبوقة كانت مدعومة خارجيا، إذ غلت يد سلطة مبارك عن التعامل العنيف مع الفضائيات والصحافة التي شهدت تكاثرا وجرأة مدهشة ضد نظام مبارك، كما اجتمعت هذه الصحف –على اختلاف أطيافها- على تلميع شخصية محمد البرادعي كقائد للتغيير. (جـ) المنظمات الحقوقية والشبابية والتي شهدت تكاثرا أيضا واستقطابا للشباب الذي يتمخض عن ثورة، وصارت تعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل عن التغيير والنظام المنشود (الليبرالي). وقد استفاد الإسلاميون من هذه الحرية عبر الانترنت والصحافة، بل وسمح بقنوات فضائية دينية مثلت ركنا قويا في رفع الوعي بالإسلام وإن تجنبت الحديث في السياسة مباشرة أغلب الوقت.
3. وظلت مؤسسات إدارة الثروة والنفوذ محتكرة بيد الدولة بشكل كامل، إلا أن ظهور الانترنت ودخول مصر في اتفاقيات التجارة الحرة مكَّن كثيرا من المشروعات الصغيرة أن تنشأ عبر الانترنت متجاوزة لسلطان الدولة، كما جعل كثيرا من المشروعات الكبيرة ذات امتدادات فوق الدولة، فلم تعد سيطرة الدولة على كل المشروعات داخل أرضها كما كانت في السابق.
4. كذلك ظلت مؤسسات التشريع والقضاء محتكرة بيد السلطة، وللسلطة نفوذ كامل عليها، إلا أنها تأثرت أيضا بالمناخ الثوري والقوة الخارجية المطالبة بالإصلاحات الديمقراطية، فشهدت أعوام 2005 حركة نادي القضاة المطالبة بالإصلاح، وغلت يد السلطة جزئيا عن انتخابات البرلمان 2005 مما أوصل أكبر نسبة معارضة في تاريخ حقبة العسكر، وصارت هذه الحركات القضائية التي تفاعلت معها معارضة البرلمان –بالإضافة لحركات الشباب والعمال- مصدر إزعاج للسلطة ومصدرا آخر للوعي والتثوير.
أفضى كل هذا، مع شرارة نجاح الثورة التونسية في إسقاط نظام بن علي، إلى احتشاد شعبي واسع وغير مسبوق في 25 يناير تحول إلى احتجاج عنيف كسرت فيه جهاز الشرطة يوم 28 يناير، ومع امتناع الجيش عن مواجهة الثورة، لم يكن أمام مبارك مفر إلا الرحيل.
وهنا بدأت المعركة بين أجنحة إزالة النظام؛ الشعب الذي لم يصدق أنه بهذه القوة أن إزالة مبارك بهذه السهولة. والعسكر الذين فوجئوا أن الشعب يطلب أكثر من إزالة مبارك نفسه.. وجرى الأمر بين شد وجذب ومعارك دموية، وفوق الجميع كانت أمريكا تفضل حكما مدنيا علمانيا تسنده القوة العسكرية من الخلف. وأسفر كل هذا عن نجاح محمد مرسي (القيادي بالإخوان المسلمين) رئيسا للجمهورية، كان فيها أفضل المتاح بالنسبة للجميع، فهو أفضل للإسلاميين من نظام مبارك، وأفضل للجيش وأمريكا من تشدد حازم أبو إسماعيل أو خيرت الشاطر ومن اضطراب شعبي إسلامي في مصر التي أسفرت عن قوة غير متوقعة للتيار الإسلامي، ولكل طرف أهداف أخرى.
وكما هو المتوقع، سعت الثورة إلى تمكين المجتمع (وإن أخطأ ممثلوها فاعتمدوا النهج الإصلاحي البطيئ الذي لا يصلح للثورات) فخرج دستور يغل من سلطات الشرطة والعسكر ويعيد العمل بنظام الوقف، وكان لدى مرسي مشروع عنوان "تمكين المجتمع". بينما قضى النظام عاما يجمع نفسه ويلملم شتاته ويحارب من خلال مؤسسات القوة (الجيش والشرطة) ومؤسسات النفوذ والثروة، ومؤسسة القضاء في القضاء على هذه الثورة. حتى تم له الأمر بانقلاب 3 يوليو 2013.
وكما هو المتوقع أيضا، فقد ألغى الدستور القديم وألغى البرلمان المنتخب، ووضع دستورا تسلطيا أزال فيه كل أثر لتمكين المجتمع، ولم ينتخب حتى بعد عامين برلمانا وظل يحكم بالقرار المنفرد المتسلط الذي يخترق حتى الدستور الذي وضعه هو.
وتشهد المرحلة الحالية نموا في أمرين وإخفاقا في أمرين:
1. نمو في الوعي الذي ألهبته مجازر الانقلاب الكاشفة عن طبيعة الدولة الحديثة ومؤسساتها.2. ونمو بطيئ ضعيف في استعمال السلاح ومقاومة السلطة الحاكمة.
ويبقى أمران لا بد من حسمهما على مستوى الوعي ومستوى التصرف فعليا:
3. مؤسسات التشريع والقضاء، إذ يحتاج الإسلاميون لتعميم مسائل وطرق ومناهج "أهل الحل والعقد" و"القضاء العرفي" لتكون بديلا حاضرا ونموذجا مطروحا في مرحلة الفوضى.
4. مؤسسات الثروة والنفوذ، إذ يحتاج الإسلاميون لتحديد أهم المؤسسات وكيف يجب التعامل مع كل منها، إما بالتفكيك الكلي أو الجزئي أو تركها على حالها. مع العلم بأن تفتيت مؤسسات الدولة وإعادة بنائها أحد أهم مظاهر الثورات الحقيقية؛ ولن ينكسر الفاصل الصلب بين الطبقة الحاكمة والمجتمع دون الثورة الشاملة وإعادة السلطة للمجتمع وتفتيت الطبقة الحاكمة؛ وينبغي ذكر أن محاولة إصلاح النظام لن ينتج عنها إلا إحلال طبقة حاكمة محل الأخري ما دامت بنية النظام واحدة مهما كانت تتمتع الطبقة الجديدة بالنزاهه حيث أن قوة النظام وقدرته علي احتواء أي قوي تدخله أقوي من أي محاولات.
(10)ملاحظات وخلاصات
من خلال استعراض وتحليل عوامل القوة نلاحظ الآتي:
1) لحظات قوة الأمة هي اللحظات التي تتوازن فيها قوة الدولة مع قوة المجتمع (رسوم تداخل المنحنيات)، بينما لحظات الضعف والنكبة هي التي تتغول فيها الدولة على حساب المجتمع، فيكون منحنى قوة السلطة أعلى من منحنى قوة المجتمع، وأسوأ الفترات هي حين تنفصل المنحنيات تماما، فساعتها تكون قوة السلطة في أعلى مراحلها وتكون قوة المجتمع في أضعف حالاتها.
2) المنحنى في عهد الاحتلال الإنجليزي يشبه المنحنى في عهد الأسرة العلوية ويشبه حقبة العسكر، ما يعني أن الاستبداد هو الوجه الآخر للاحتلال. هذا مع العلم مع أن الاستبداد وقت الأسرة العلوية كان "استبدادا وطنيا" بخلاف الواقع الآن الذي هو مزيج من "الاحتلال والاستبداد".
3) بالرغم من عدد المحاولات الثورية ولحظات النهوض إلا أن أيها لم ينجح، إما بنزول الاحتلال بنفسه (الاحتلال الإنجليزي) أو باستباق الثورة بانقلاب عسكري (يوليو، وفبراير 2011) أو بخدعة الديمقراطية (ثورة 19، انتخابات 2012). وهو ما ينبغي أن ينتبه له صناع القرار في المرحلة الثورية الحالية وأن يحسبوا حسابه.
4) امتلاك الشعب للسلاح هو أحد أهم موانع الاستبداد والاحتلال.. وفوق امتلاك السلاح الوعي بالحق في امتلاكه والحق في استعماله ضد أي ظلم أو قهر أو سلطة مستبدة. إن حالة التخويف من انتشار السلاح أو منعه تصطدم بثوابت الدين وقواعد التاريخ وتحاصر المفكرين والعاملين والميدانيين، فضلا عن خطورتها في تزييف الوعي.
5) الوعي أحد أهم أسلحة المعركة، وهو مهمة المجتمع، ويرتبط بوجود قيادات مجتمعية فاعلة ومجتمع متماسك مترابط، وتدمير الوعي أحد أهم أهداف الاستبداد والاحتلال.
6) ضرورة إلغاء نظام التجنيد الإجباري الذي يدجن الشعب، والعودة للمزاوجة بين نظام الإلزام ونظام التطوع، وفي تراثنا الفقهي والتاريخي مخزون ضخم من قيم الجهاد وضوابطه، ثم في الأنظمة المعاصرة بدائل كثيرة تعصم من كوارث التجنيد الإجباري والقيم العسكرية المسيطرة عليه.
7) لا بديل عن كسر احتكار الدولة للوعي والتعليم من خلال سيطرتها على المؤسسات التعليمية وعلى الصحافة والإعلام، فالعودة للكتاتيب والتعليم التقليدي ومؤسسات التعليم الموازي والتعليم المنزلي والتعليم الحر والتعليم المفتوح.. كل هذا ضرورة في إنشاء الجيل القادم ومنع خضوعه لمنظومة فكرية صادرة عن السلطة.
8) زيادة الاستثمار في مجال صناعة الميديا بوسائل متعددة وتدريب كوادر في كافة مجالات الميديا السنيما الإذاعة التليفزيون وغيرها ومنازعة الطبقة الحاكمة في كل مجالات الإعلام وعدم ترك أي مساحة منفردة لهم.
9) الأوقاف أحد أهم روافد قوة المجتمع، ومسألة الأوقاف (كجزء من مسألة استقلال المجتمع) هي مسألة حياة أو موت. والأوقاف قادرة على حل مشكلات احتكار السلطة للتعليم والإعلام والمؤسسات جميعا: التشريعية والتنفيذية والقضائية، بل وتستطيع قضية الوقف حل مشكلة احتكار السلاح أيضا.
10) لا بد من دراسات متخصصة في أمر النظام النقدي والمالي المنشود للوقوف على الشكل الأمثل له في الواقع المعاصر، في ظل الهيمنة العالمية على مجال المال والنقد.
11) نزع مهمة التشريع من السلطة واستقلال المؤسسات النيبابية والقانونية هو من صميم النظام الإسلامي، وهو إجراء مستقر يتخذه المستبد والمحتل للسيطرة عليه، ولهذا فلا مناص من العودة والمناداة بهذا النظام وتبيين فضائله في معركة المواجهة.
12) تنظيم القضاء الشرعي والعرفي فهو البديل المجتمعي الناجز والأسرع والأقوى للقضاء المدني (العلماني)، مع تعظيم شأن الشريعة وجعلها أمرا لا يقبل النقاش فتكون سلطة فوق المحاكم المدنية وسبيلا إلى إصلاحها تدريجيا.دد
13) ضرورة وجود قيادة للثورة، فقد سرق الإنجليز ثورة 1919 بتسليمها لزعيم مضمون الولاء، وسرقوا ثورة 52 بتلميع شخصية ضابط صغير في الثلاثينات من عمره، وهذا ما فعلوه في ثورة 2011 مع شخصية السيسي، وما يزال بقاء مرسي حيا يمثل لهم إشكالا في الشرعية. ولا بد من أن تتمتع القيادة بالنزاهة والكفاءة، فمشكلة النزاهة هي ما أودت بثورات 19 و52، ومشكلة الكفاءة كانت ضمن مشكلات الثورة العرابية وثورة يناير.
14) وضوح وقوة الخطاب الثوري، فالثورات الناجحة هي التي كان لها خطاب حاسم صريح، والجماهير لا يحركها إلا الوضوح والقوة.
15) السعي نحو امتلاك أدوات القوة، فهذه الدراسة تثبت أن غياب أحد أدوات القوة يكون دائما في صالح الاستبداد أو الاحتلال.
***
وبالإجمال فهذه هي صورة تطور ميزان القوة في المجتمع المصري منذ ما قبل الحملة الفرنسية وحتى ثورة يناير، ويبدو فيها واضحا وجليا كيف كان المجتمع أقوى من السلطة في مجمل ميزان القوى، ثم تدرج الأمر لتكون السلطة أكثر تغولا وانفصالا عن المجتمع.
كما يبدو واضحا أن الحالات الثورية وحالات المقاومة هي النقاط التي يقترب فيها المجتمع من الحصول علي السلطة والتي تواجه بالقوة الباطشة للحفاظ علي السلطة بعيدا عن المجتمع. وهذا الأمر يفسر لم كانت هذه الفترة هي فترة ضعفنا ونكباتنا وهزائمنا الطويلة.
والشكل التالي يبين منحني القوة للمجتمع والسلطة عبر القرنين الماضيين، في التسع مراحل المتتابعة
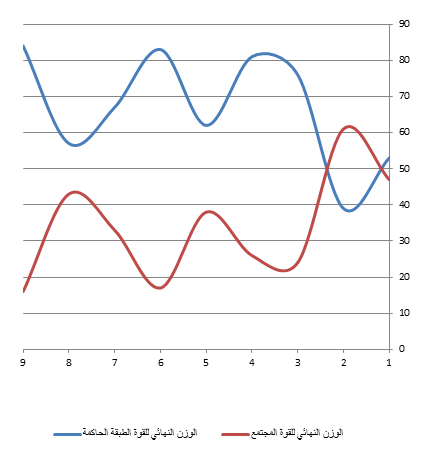
نشر في ساسة بوست
اقرأ أولا: تبسيط تاريخ مصر الحديث (1) تبسيط تاريخ مصر الحديث (2)
(9)ثورة 25 يناير
شاخ نظام يوليو وبدت آثاره السلبية مع الشيخوخة الطويلة لحسني مبارك (ثمانون عاما)، وصارت مصر مرتعا للفساد، وقد اجتمعت عوامل إزالة نظام مبارك وإن لم تجتمع عوامل حدوث ثورة. على هذا النحو الآتي:
1. ظل السلاح محتكرا بيد السلطة، الجيش والأجهزة الأمنية، ومن فوقهما القوة الخارجية (أمريكا) صاحبة النفوذ الفعلي الأكبر على الساحة المصرية. وقد التقت الرغبة الأمريكية مع رغبة الجيش في إزاحة نظام مبارك. أما الجيش فلأنه لا يؤيد انتقال السلطة لمدني (جمال مبارك الغلام الصغير معدوم المواهب)، وأما أمريكا فلظنها أنها تستطيع إقامة حكم ديمقراطي في مصر يجنبها مشكلة الإرهاب ويحتوي التيارات الإسلامية فيدجنها ويخضعها لمنظومة الديمقراطية. فلما اجتمعت هاتان الرغبتان، حسم أمر نظام مبارك وجرى انقلاب عسكري –متقنع بقناع الثورة وإرادة الشعب- عليه في 11 فبراير.
2. شهد الوعي طفرة كبرى في السنوات الست الأخيرة من حكم مبارك، وذلك لأكثر من سبب أهمها: (أ) الانترنت الذي مثل كسرا لاحتكار المعلومة وبيئة للمقاومة والتقاء الشباب وأفكارهم الثورية وسبل تطبيقها عمليا. (ب) الإعلام الذي شهد موجة حرية غير مسبوقة كانت مدعومة خارجيا، إذ غلت يد سلطة مبارك عن التعامل العنيف مع الفضائيات والصحافة التي شهدت تكاثرا وجرأة مدهشة ضد نظام مبارك، كما اجتمعت هذه الصحف –على اختلاف أطيافها- على تلميع شخصية محمد البرادعي كقائد للتغيير. (جـ) المنظمات الحقوقية والشبابية والتي شهدت تكاثرا أيضا واستقطابا للشباب الذي يتمخض عن ثورة، وصارت تعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل عن التغيير والنظام المنشود (الليبرالي). وقد استفاد الإسلاميون من هذه الحرية عبر الانترنت والصحافة، بل وسمح بقنوات فضائية دينية مثلت ركنا قويا في رفع الوعي بالإسلام وإن تجنبت الحديث في السياسة مباشرة أغلب الوقت.
3. وظلت مؤسسات إدارة الثروة والنفوذ محتكرة بيد الدولة بشكل كامل، إلا أن ظهور الانترنت ودخول مصر في اتفاقيات التجارة الحرة مكَّن كثيرا من المشروعات الصغيرة أن تنشأ عبر الانترنت متجاوزة لسلطان الدولة، كما جعل كثيرا من المشروعات الكبيرة ذات امتدادات فوق الدولة، فلم تعد سيطرة الدولة على كل المشروعات داخل أرضها كما كانت في السابق.
4. كذلك ظلت مؤسسات التشريع والقضاء محتكرة بيد السلطة، وللسلطة نفوذ كامل عليها، إلا أنها تأثرت أيضا بالمناخ الثوري والقوة الخارجية المطالبة بالإصلاحات الديمقراطية، فشهدت أعوام 2005 حركة نادي القضاة المطالبة بالإصلاح، وغلت يد السلطة جزئيا عن انتخابات البرلمان 2005 مما أوصل أكبر نسبة معارضة في تاريخ حقبة العسكر، وصارت هذه الحركات القضائية التي تفاعلت معها معارضة البرلمان –بالإضافة لحركات الشباب والعمال- مصدر إزعاج للسلطة ومصدرا آخر للوعي والتثوير.
أفضى كل هذا، مع شرارة نجاح الثورة التونسية في إسقاط نظام بن علي، إلى احتشاد شعبي واسع وغير مسبوق في 25 يناير تحول إلى احتجاج عنيف كسرت فيه جهاز الشرطة يوم 28 يناير، ومع امتناع الجيش عن مواجهة الثورة، لم يكن أمام مبارك مفر إلا الرحيل.
وهنا بدأت المعركة بين أجنحة إزالة النظام؛ الشعب الذي لم يصدق أنه بهذه القوة أن إزالة مبارك بهذه السهولة. والعسكر الذين فوجئوا أن الشعب يطلب أكثر من إزالة مبارك نفسه.. وجرى الأمر بين شد وجذب ومعارك دموية، وفوق الجميع كانت أمريكا تفضل حكما مدنيا علمانيا تسنده القوة العسكرية من الخلف. وأسفر كل هذا عن نجاح محمد مرسي (القيادي بالإخوان المسلمين) رئيسا للجمهورية، كان فيها أفضل المتاح بالنسبة للجميع، فهو أفضل للإسلاميين من نظام مبارك، وأفضل للجيش وأمريكا من تشدد حازم أبو إسماعيل أو خيرت الشاطر ومن اضطراب شعبي إسلامي في مصر التي أسفرت عن قوة غير متوقعة للتيار الإسلامي، ولكل طرف أهداف أخرى.
وكما هو المتوقع، سعت الثورة إلى تمكين المجتمع (وإن أخطأ ممثلوها فاعتمدوا النهج الإصلاحي البطيئ الذي لا يصلح للثورات) فخرج دستور يغل من سلطات الشرطة والعسكر ويعيد العمل بنظام الوقف، وكان لدى مرسي مشروع عنوان "تمكين المجتمع". بينما قضى النظام عاما يجمع نفسه ويلملم شتاته ويحارب من خلال مؤسسات القوة (الجيش والشرطة) ومؤسسات النفوذ والثروة، ومؤسسة القضاء في القضاء على هذه الثورة. حتى تم له الأمر بانقلاب 3 يوليو 2013.
وكما هو المتوقع أيضا، فقد ألغى الدستور القديم وألغى البرلمان المنتخب، ووضع دستورا تسلطيا أزال فيه كل أثر لتمكين المجتمع، ولم ينتخب حتى بعد عامين برلمانا وظل يحكم بالقرار المنفرد المتسلط الذي يخترق حتى الدستور الذي وضعه هو.
وتشهد المرحلة الحالية نموا في أمرين وإخفاقا في أمرين:
1. نمو في الوعي الذي ألهبته مجازر الانقلاب الكاشفة عن طبيعة الدولة الحديثة ومؤسساتها.2. ونمو بطيئ ضعيف في استعمال السلاح ومقاومة السلطة الحاكمة.
ويبقى أمران لا بد من حسمهما على مستوى الوعي ومستوى التصرف فعليا:
3. مؤسسات التشريع والقضاء، إذ يحتاج الإسلاميون لتعميم مسائل وطرق ومناهج "أهل الحل والعقد" و"القضاء العرفي" لتكون بديلا حاضرا ونموذجا مطروحا في مرحلة الفوضى.
4. مؤسسات الثروة والنفوذ، إذ يحتاج الإسلاميون لتحديد أهم المؤسسات وكيف يجب التعامل مع كل منها، إما بالتفكيك الكلي أو الجزئي أو تركها على حالها. مع العلم بأن تفتيت مؤسسات الدولة وإعادة بنائها أحد أهم مظاهر الثورات الحقيقية؛ ولن ينكسر الفاصل الصلب بين الطبقة الحاكمة والمجتمع دون الثورة الشاملة وإعادة السلطة للمجتمع وتفتيت الطبقة الحاكمة؛ وينبغي ذكر أن محاولة إصلاح النظام لن ينتج عنها إلا إحلال طبقة حاكمة محل الأخري ما دامت بنية النظام واحدة مهما كانت تتمتع الطبقة الجديدة بالنزاهه حيث أن قوة النظام وقدرته علي احتواء أي قوي تدخله أقوي من أي محاولات.
(10)ملاحظات وخلاصات
من خلال استعراض وتحليل عوامل القوة نلاحظ الآتي:
1) لحظات قوة الأمة هي اللحظات التي تتوازن فيها قوة الدولة مع قوة المجتمع (رسوم تداخل المنحنيات)، بينما لحظات الضعف والنكبة هي التي تتغول فيها الدولة على حساب المجتمع، فيكون منحنى قوة السلطة أعلى من منحنى قوة المجتمع، وأسوأ الفترات هي حين تنفصل المنحنيات تماما، فساعتها تكون قوة السلطة في أعلى مراحلها وتكون قوة المجتمع في أضعف حالاتها.
2) المنحنى في عهد الاحتلال الإنجليزي يشبه المنحنى في عهد الأسرة العلوية ويشبه حقبة العسكر، ما يعني أن الاستبداد هو الوجه الآخر للاحتلال. هذا مع العلم مع أن الاستبداد وقت الأسرة العلوية كان "استبدادا وطنيا" بخلاف الواقع الآن الذي هو مزيج من "الاحتلال والاستبداد".
3) بالرغم من عدد المحاولات الثورية ولحظات النهوض إلا أن أيها لم ينجح، إما بنزول الاحتلال بنفسه (الاحتلال الإنجليزي) أو باستباق الثورة بانقلاب عسكري (يوليو، وفبراير 2011) أو بخدعة الديمقراطية (ثورة 19، انتخابات 2012). وهو ما ينبغي أن ينتبه له صناع القرار في المرحلة الثورية الحالية وأن يحسبوا حسابه.
4) امتلاك الشعب للسلاح هو أحد أهم موانع الاستبداد والاحتلال.. وفوق امتلاك السلاح الوعي بالحق في امتلاكه والحق في استعماله ضد أي ظلم أو قهر أو سلطة مستبدة. إن حالة التخويف من انتشار السلاح أو منعه تصطدم بثوابت الدين وقواعد التاريخ وتحاصر المفكرين والعاملين والميدانيين، فضلا عن خطورتها في تزييف الوعي.
5) الوعي أحد أهم أسلحة المعركة، وهو مهمة المجتمع، ويرتبط بوجود قيادات مجتمعية فاعلة ومجتمع متماسك مترابط، وتدمير الوعي أحد أهم أهداف الاستبداد والاحتلال.
6) ضرورة إلغاء نظام التجنيد الإجباري الذي يدجن الشعب، والعودة للمزاوجة بين نظام الإلزام ونظام التطوع، وفي تراثنا الفقهي والتاريخي مخزون ضخم من قيم الجهاد وضوابطه، ثم في الأنظمة المعاصرة بدائل كثيرة تعصم من كوارث التجنيد الإجباري والقيم العسكرية المسيطرة عليه.
7) لا بديل عن كسر احتكار الدولة للوعي والتعليم من خلال سيطرتها على المؤسسات التعليمية وعلى الصحافة والإعلام، فالعودة للكتاتيب والتعليم التقليدي ومؤسسات التعليم الموازي والتعليم المنزلي والتعليم الحر والتعليم المفتوح.. كل هذا ضرورة في إنشاء الجيل القادم ومنع خضوعه لمنظومة فكرية صادرة عن السلطة.
8) زيادة الاستثمار في مجال صناعة الميديا بوسائل متعددة وتدريب كوادر في كافة مجالات الميديا السنيما الإذاعة التليفزيون وغيرها ومنازعة الطبقة الحاكمة في كل مجالات الإعلام وعدم ترك أي مساحة منفردة لهم.
9) الأوقاف أحد أهم روافد قوة المجتمع، ومسألة الأوقاف (كجزء من مسألة استقلال المجتمع) هي مسألة حياة أو موت. والأوقاف قادرة على حل مشكلات احتكار السلطة للتعليم والإعلام والمؤسسات جميعا: التشريعية والتنفيذية والقضائية، بل وتستطيع قضية الوقف حل مشكلة احتكار السلاح أيضا.
10) لا بد من دراسات متخصصة في أمر النظام النقدي والمالي المنشود للوقوف على الشكل الأمثل له في الواقع المعاصر، في ظل الهيمنة العالمية على مجال المال والنقد.
11) نزع مهمة التشريع من السلطة واستقلال المؤسسات النيبابية والقانونية هو من صميم النظام الإسلامي، وهو إجراء مستقر يتخذه المستبد والمحتل للسيطرة عليه، ولهذا فلا مناص من العودة والمناداة بهذا النظام وتبيين فضائله في معركة المواجهة.
12) تنظيم القضاء الشرعي والعرفي فهو البديل المجتمعي الناجز والأسرع والأقوى للقضاء المدني (العلماني)، مع تعظيم شأن الشريعة وجعلها أمرا لا يقبل النقاش فتكون سلطة فوق المحاكم المدنية وسبيلا إلى إصلاحها تدريجيا.دد
13) ضرورة وجود قيادة للثورة، فقد سرق الإنجليز ثورة 1919 بتسليمها لزعيم مضمون الولاء، وسرقوا ثورة 52 بتلميع شخصية ضابط صغير في الثلاثينات من عمره، وهذا ما فعلوه في ثورة 2011 مع شخصية السيسي، وما يزال بقاء مرسي حيا يمثل لهم إشكالا في الشرعية. ولا بد من أن تتمتع القيادة بالنزاهة والكفاءة، فمشكلة النزاهة هي ما أودت بثورات 19 و52، ومشكلة الكفاءة كانت ضمن مشكلات الثورة العرابية وثورة يناير.
14) وضوح وقوة الخطاب الثوري، فالثورات الناجحة هي التي كان لها خطاب حاسم صريح، والجماهير لا يحركها إلا الوضوح والقوة.
15) السعي نحو امتلاك أدوات القوة، فهذه الدراسة تثبت أن غياب أحد أدوات القوة يكون دائما في صالح الاستبداد أو الاحتلال.
***
وبالإجمال فهذه هي صورة تطور ميزان القوة في المجتمع المصري منذ ما قبل الحملة الفرنسية وحتى ثورة يناير، ويبدو فيها واضحا وجليا كيف كان المجتمع أقوى من السلطة في مجمل ميزان القوى، ثم تدرج الأمر لتكون السلطة أكثر تغولا وانفصالا عن المجتمع.
كما يبدو واضحا أن الحالات الثورية وحالات المقاومة هي النقاط التي يقترب فيها المجتمع من الحصول علي السلطة والتي تواجه بالقوة الباطشة للحفاظ علي السلطة بعيدا عن المجتمع. وهذا الأمر يفسر لم كانت هذه الفترة هي فترة ضعفنا ونكباتنا وهزائمنا الطويلة.
والشكل التالي يبين منحني القوة للمجتمع والسلطة عبر القرنين الماضيين، في التسع مراحل المتتابعة
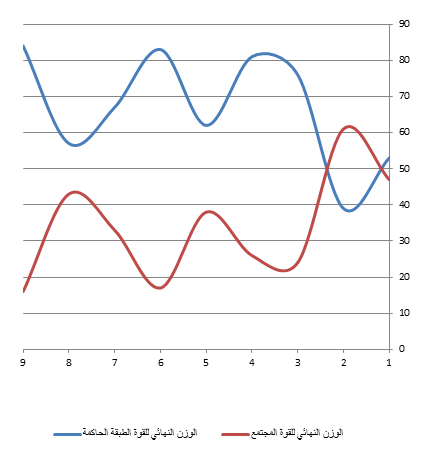
نشر في ساسة بوست
Published on April 21, 2016 15:38
April 20, 2016
حزب العدالة والتنمية .. المؤسسون
اقرأ أولا:
موجز قصة أردوغان قصة الخلاف بين أردوغان وأربكان
لم يكن أردوغان وحده بطبيعة الحال، بل بلغ عدد الموقعين على عريضة تأسيس الحزب 71 عضوا، ثم انضم إليهم في اليوم نفسه 53 نائبا بالبرلمان ليصير عددهم 124 عضواكان على رأس المؤسسين صديق أردوغان ورفيق دربه عبد الله غُل، وهو أكبر من أردوغان بأربع سنوات، وُلِد (29 أكتوبر 1950م) في قيصري، من محافظات وسط الأناضول، ذات الطابع التقليدي الشرقي الإسلامي، لأسرة متدينة ومهتمة بالسياسة إذ كان أبوه مرشحا برلمانيا عن حزب السلامة الوطني (1973م) فتأثر مبكرا بزعامة نجم الدين أربكان، ودرس بمدارس الأئمة والخطباء في المرحلة الثانوية، ثم تخرج من كلية الاقتصاد جامعة اسطنبول (1972م)، وحصل على الماجستير، وكانت رسالته للدكتوراه عن "تطور العلاقات الاقتصادية بين تركيا والعالم الإسلامي" (1978م)، وعمل في بنك التنمية الإسلامي بجدة كخبير اقتصادي (1983 – 1991م). انخرط في السياسة منذ بدأ أربكان في نشاطه السياسي (1969م)، واعتقل بعيد الانقلاب العسكري (1980م)، وانتخب عضوا عن حزب الرفاه لمحافظة قيصرى (1991م)، وصار عضوا في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان في ذات الوقت الذي تولى فيه منصب العلاقات الدولية لحزب الرفاه (1995 – 2000م)، ثم وزير دولة للشئون الخارجية في حكومة أربكان القصيرة (1996 – 1997م)، وانتقل إلى حزب الفضيلة من بعد ما أغلق حزب الرفاه ثم خسر في الانتخابات الداخلية أمام رجائي قوطان، ثم أغلق حزب الفضيلة، فانشق مع مجموعته عن أربكان وأسسوا حزب العدالة والتنمية، وبخلاف الأثر المباشر لنجم الدين أربكان، فلقد تأثر جول بالشاعر والأديب الإسلامي الكبير نجيب فاضل والمفكر والأديب التركي المعروف جميل مريتشوهو –بذلك- يشبه صاحبه من عدة وجوه، فكلاهما من البيئة الجغرافية والطبقة الاجتماعية التي تمثل نقيضا لما أريد لتركيا بل إن عجلة تركيا التحديثية جعلتهم من ضحايا تلك السياسات، ثم دراستهما في مدارس الأئمة والخطباء، ثم التقاؤهما في المناخ الفكري والحركي الإسلامي ضمن حركة الفكر الوطني، ثم دراستهما الاقتصاد، ثم الخلاف مع أربكان.
وبالإضافة إلى أردوغان وجُل حوت أسماء المؤسسين شخصيات أخرى، برز منها العديد في المناصب الحكومية التي قام بأمرها حزب العدالة والتنمية، من أهمهم:
- بولنت أرينتش؛ وهو شخصية ذات ثقل وظلت موضع تجاذب بين فريق أربكان وفريق أردوغان لحظة تأسيس الحزب- علي بابا جان: الذي تولى ملف الاقتصاد في بداية الحزب، وكان حينئذ في الرابعة والثلاثين من عمره، وقام بجولاته الخارجية لصالح هذا الملف، وهو مهندس صناعي، وُلِد في أنقرة (1967م) وتخرج في جامعة أنقرة محققا المركز الأول على دفعته (1985م) وحصل على بكالوريوس الهندسة الصناعية (1989م) من جامعة الشرق الأوسط للتقنية بتفوق، ثم حصل على منحة فدرس وحاز الماجستير (1992م) في إدارة الأعمال والتسويق من أمريكا وعمل بها لعامين في شركة تقدم استشارات لكبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك، ثم عاد إلى تركيا (1994م) وأسس شركة نسيج، وكان مستشارا لرئيس بلدية أنقرة (1994م)، وكان رئيس البلدية وقتئذ من حزب الرفاه، ثم ودخل عالم السياسة كمؤسس لحزب العدالة والتنمية، وانتخب في برلمان (2002م) عن حزب العدالة والتنمية، وصار أصغر وزير (35 عاما) إذ تولى وزارة الاقتصاد والخارجية، وكان المسؤول المفاوض في انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
- حلمي جولار؛ وهو مهندس بقسم المعادن، وُلِد (1946م) في مدينة أوردو التي تقع على ساحل البحر الأسود في شمال شرق البلاد، وتشتهر المدينة بصناعة البندق وبمناطق جذب سياحية، وتخرج في قسم التعدين من جامعة الشرق الأوسط للتقنية، عمل مهندسا في الشركة التركية لصناعة الطيران وقاد فريق عمل في بحوث الفضاء، وكان في سن الخامسة والخمسين لحظة تأسيس الحزب، وصار بعدئذ وزير الطاقة وكان مسؤولا عن إعداد المشاريع في فترة تأسيس الحزب وكانوا قد أعدوا 300 مشروع قبل الانطلاقة، وخطط لبناء ثلاث محطات طاقة نووية مع الاستثمار في الطاقة الكهرومائية بالإضافة إلى تنمية قطاع التعدينعلى أنه لا ينبغي بحال أن يُغفل اسم رجل آخر في مرحلة التأسيس، وإن خلت منه قائمة المؤسسين، ذلك هو أحمد داود أوغلو الذي يُلقب بمهندس سياسات العدالة والتنمية، فهو بمثابة "المؤسس الفكري" للرؤية التركية، وقد كان حاضرا منذ البداية وإن لم يكن في صدارة المشهد. وإذا ذُكِر حزب العدالة والتنمية فإنه يُثير في الذهن أسماء هؤلاء الثلاثة: أردوغان، عبد الله جل، أحمد داود أوغلو.
وهو مفكر استراتيجي وأستاذ للعلاقات الدولية، وُلِد (26 فبراير 1959م) في بلدة تاشكينت عند قمة جبال طوروس وهي تابعة لمحافظة قونية، درس الثانوية في اسطنبول، ثم تخرج في كلية الاقتصاد وكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، حصل على الماجستير في الإدارة العامة وعلى الدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة البوسفور، ودرَّس في تركيا بجامعة بوغاز ايتشي وفي الأكاديميات العسكرية وفي الجامعة الإسلامية العالية في ماليزيا، وهو يتقن أربع لغات: التركية والإنجليزية والألمانية والعربية، وقد تعرف على عبد الله جُل في الثمانينات، وعُيِّنَ مستشارا خاصا لرئيس الوزراء أردوغان للشؤون الخارجية (2002م)ولداود أوغلو عدد من المؤلفات أهمها ثلاثة: الفلسفة السياسية، العالم الإسلامي في مهب التحولات الحضارية، العمق الاستراتيجي:
فأما كتابه "الفلسفة السياسية" فيتحدث عن التناقض الجوهري بين النظامين الإسلامي والغربي في السياسة، وكيف أن تناقض العقائد والتصور العام للوجود انعكس على النظم السياسية فأنشأت اختلافا أساسيا لا يمكن تجاوزه بين النموذجين، إذ لا يمكن التقاء العلمانية مع الإسلام، كما ويستحيل في الإسلام نشوء "قاعدة علمانية للمعرفة البشرية"وأما كتابه العالم الإسلامي في مهب التحولات الحضارية فيحمل على الفلسفة الغربية التي تنتج كل حين نظريتها عن "نهاية التاريخ" التي يتكثف فيها الغرور الغربي الذي يظن أن ما وصل إليه هو كلمة النهاية التي تطوى بعدها صحيفة التقدم الإنساني، ويذهب إلى القول بأن أزمة الفلسفة الغربية كامنة في القيم التي تعتنقها، ولهذا فلم يقدم التقدم العلمي أو الرفاه الاقتصادي العدل للبشرية ولا حتى الأمان للإنسان الغربي نفسه، كذلك فإن انهيار الاتحاد السوفيتي لا يعني نهاية التاريخ بل يعني مجرد تحول في المراكز الحضارية التي تشهد محاولات لتحول آخر من الأطلسي (كمحور الحضارة الغربية) إلى قلب أوروبا في إطار المحاولة الأوروبية للاتحاد ويبدو كذلك أن تحولا آخر يلوح في الأفق وهو المحور الآسيوي حيث الصين واليابان ودول جنوب شرق آسيا. غير أن هذا التحول نحو الشرق ليس مهما إلا بقدر ما تقدمه الفلسفة التي يطرحها هذا المحور. ثم يخلص إلى القول بأن المرشح الوحيد لإحداث تحول حضاري حقيقي هو الإسلام الذي يملك من القيم والمبادئ ما يُمَكِّنه من طرح رؤية جديدة ومنظومة مؤسسات وعلاقات قائمة على مبادئ وقيم وأخلاق مطلقة لا تملك معها أن تنشئ من المؤسسات والسياسات ما ينتهكها.
وأما كتابه "العمق الاستراتيجي" وهو أهم كتبه، والذي يعده الكثيرون أهم أدبيات حزب العدالة والتنمية، فينصب على إعادة تعريف موقع تركيا ودورها في العالم، وكيف أنها لا تملك –طبقا لنظريته في العمق الاستراتيجي- سوى أن تكون قوة عالمية بحكم موقعها الجغرافي وتاريخها العريق وثقلها الثقافي شرط أن تتصالح مع هويتها وتعيد وصل ما انقطع من العلاقات العثمانية بمجالها الحيوي الذي هو عمقها الاستراتيجي، وهو يقرر أن أي نظرية استراتيجية تكون عديمة الكفاءة إذا طرحت "تناقضات في موضوعي الهوية والوعي التاريخي باعتبارهما عامليْن أساسييْن في ضعف الاستعداد النفسي"وفيما بعد سيعمل داود أوغلو مستشارا لأردوغان ثم سفيرا ثم وزيرا للخارجية، وحينئذ سيتحول كتابه "العمق الاستراتيجي" من "أحلام أكاديمي مسلم" إلى برنامج للتطبيقنشر في تركيا بوست
بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص323. ويشبهه البعض بطه حسين في العالم العربي، لأنه مفكر وأديب ومترجم ويتقن الفرنسية، وقد أنجز هذا برغم فقدان بصره. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص298 وما بعدها؛ http://www.abdullahgul.gen.tr بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص318، 319. Rabasa, Larrabee: The Rise of Political Islam, p. 14. AK parti website: http://www.akparti.org.tr كِرِم أوكْتِم: الأمة الغاضبة ص250؛ AK parti website: http://www.akparti.org.tr أحمد داود أوغلو: الفلسفة السياسية ص17. أحمد داود أوغلو: العمق الاستراتيجي.. موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية، ترجمة: محمد جابر ثلجي وطارق عبد الجليل (الدوحة وبيروت، مركز الجزيرة للدراسات والدار العربية للعلوم ناشرون، 2011م) ص82. Rabasa, Larrabee: The Rise of Political Islam, p. 75. كِرِم أوكْتِم: الأمة الغاضبة ص255. Ömer Taspinar: Turkey’s Middle East Policies, p. 14; Aydin, Çakır: Political Islam in Turkey, p. 3. George Friedman: The Next 100 Years: A Forecast for the 21st Century, (New York, Double day, 2009), p. 144-8, 152.
موجز قصة أردوغان قصة الخلاف بين أردوغان وأربكان
لم يكن أردوغان وحده بطبيعة الحال، بل بلغ عدد الموقعين على عريضة تأسيس الحزب 71 عضوا، ثم انضم إليهم في اليوم نفسه 53 نائبا بالبرلمان ليصير عددهم 124 عضواكان على رأس المؤسسين صديق أردوغان ورفيق دربه عبد الله غُل، وهو أكبر من أردوغان بأربع سنوات، وُلِد (29 أكتوبر 1950م) في قيصري، من محافظات وسط الأناضول، ذات الطابع التقليدي الشرقي الإسلامي، لأسرة متدينة ومهتمة بالسياسة إذ كان أبوه مرشحا برلمانيا عن حزب السلامة الوطني (1973م) فتأثر مبكرا بزعامة نجم الدين أربكان، ودرس بمدارس الأئمة والخطباء في المرحلة الثانوية، ثم تخرج من كلية الاقتصاد جامعة اسطنبول (1972م)، وحصل على الماجستير، وكانت رسالته للدكتوراه عن "تطور العلاقات الاقتصادية بين تركيا والعالم الإسلامي" (1978م)، وعمل في بنك التنمية الإسلامي بجدة كخبير اقتصادي (1983 – 1991م). انخرط في السياسة منذ بدأ أربكان في نشاطه السياسي (1969م)، واعتقل بعيد الانقلاب العسكري (1980م)، وانتخب عضوا عن حزب الرفاه لمحافظة قيصرى (1991م)، وصار عضوا في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان في ذات الوقت الذي تولى فيه منصب العلاقات الدولية لحزب الرفاه (1995 – 2000م)، ثم وزير دولة للشئون الخارجية في حكومة أربكان القصيرة (1996 – 1997م)، وانتقل إلى حزب الفضيلة من بعد ما أغلق حزب الرفاه ثم خسر في الانتخابات الداخلية أمام رجائي قوطان، ثم أغلق حزب الفضيلة، فانشق مع مجموعته عن أربكان وأسسوا حزب العدالة والتنمية، وبخلاف الأثر المباشر لنجم الدين أربكان، فلقد تأثر جول بالشاعر والأديب الإسلامي الكبير نجيب فاضل والمفكر والأديب التركي المعروف جميل مريتشوهو –بذلك- يشبه صاحبه من عدة وجوه، فكلاهما من البيئة الجغرافية والطبقة الاجتماعية التي تمثل نقيضا لما أريد لتركيا بل إن عجلة تركيا التحديثية جعلتهم من ضحايا تلك السياسات، ثم دراستهما في مدارس الأئمة والخطباء، ثم التقاؤهما في المناخ الفكري والحركي الإسلامي ضمن حركة الفكر الوطني، ثم دراستهما الاقتصاد، ثم الخلاف مع أربكان.
وبالإضافة إلى أردوغان وجُل حوت أسماء المؤسسين شخصيات أخرى، برز منها العديد في المناصب الحكومية التي قام بأمرها حزب العدالة والتنمية، من أهمهم:
- بولنت أرينتش؛ وهو شخصية ذات ثقل وظلت موضع تجاذب بين فريق أربكان وفريق أردوغان لحظة تأسيس الحزب- علي بابا جان: الذي تولى ملف الاقتصاد في بداية الحزب، وكان حينئذ في الرابعة والثلاثين من عمره، وقام بجولاته الخارجية لصالح هذا الملف، وهو مهندس صناعي، وُلِد في أنقرة (1967م) وتخرج في جامعة أنقرة محققا المركز الأول على دفعته (1985م) وحصل على بكالوريوس الهندسة الصناعية (1989م) من جامعة الشرق الأوسط للتقنية بتفوق، ثم حصل على منحة فدرس وحاز الماجستير (1992م) في إدارة الأعمال والتسويق من أمريكا وعمل بها لعامين في شركة تقدم استشارات لكبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك، ثم عاد إلى تركيا (1994م) وأسس شركة نسيج، وكان مستشارا لرئيس بلدية أنقرة (1994م)، وكان رئيس البلدية وقتئذ من حزب الرفاه، ثم ودخل عالم السياسة كمؤسس لحزب العدالة والتنمية، وانتخب في برلمان (2002م) عن حزب العدالة والتنمية، وصار أصغر وزير (35 عاما) إذ تولى وزارة الاقتصاد والخارجية، وكان المسؤول المفاوض في انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
- حلمي جولار؛ وهو مهندس بقسم المعادن، وُلِد (1946م) في مدينة أوردو التي تقع على ساحل البحر الأسود في شمال شرق البلاد، وتشتهر المدينة بصناعة البندق وبمناطق جذب سياحية، وتخرج في قسم التعدين من جامعة الشرق الأوسط للتقنية، عمل مهندسا في الشركة التركية لصناعة الطيران وقاد فريق عمل في بحوث الفضاء، وكان في سن الخامسة والخمسين لحظة تأسيس الحزب، وصار بعدئذ وزير الطاقة وكان مسؤولا عن إعداد المشاريع في فترة تأسيس الحزب وكانوا قد أعدوا 300 مشروع قبل الانطلاقة، وخطط لبناء ثلاث محطات طاقة نووية مع الاستثمار في الطاقة الكهرومائية بالإضافة إلى تنمية قطاع التعدينعلى أنه لا ينبغي بحال أن يُغفل اسم رجل آخر في مرحلة التأسيس، وإن خلت منه قائمة المؤسسين، ذلك هو أحمد داود أوغلو الذي يُلقب بمهندس سياسات العدالة والتنمية، فهو بمثابة "المؤسس الفكري" للرؤية التركية، وقد كان حاضرا منذ البداية وإن لم يكن في صدارة المشهد. وإذا ذُكِر حزب العدالة والتنمية فإنه يُثير في الذهن أسماء هؤلاء الثلاثة: أردوغان، عبد الله جل، أحمد داود أوغلو.
وهو مفكر استراتيجي وأستاذ للعلاقات الدولية، وُلِد (26 فبراير 1959م) في بلدة تاشكينت عند قمة جبال طوروس وهي تابعة لمحافظة قونية، درس الثانوية في اسطنبول، ثم تخرج في كلية الاقتصاد وكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، حصل على الماجستير في الإدارة العامة وعلى الدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة البوسفور، ودرَّس في تركيا بجامعة بوغاز ايتشي وفي الأكاديميات العسكرية وفي الجامعة الإسلامية العالية في ماليزيا، وهو يتقن أربع لغات: التركية والإنجليزية والألمانية والعربية، وقد تعرف على عبد الله جُل في الثمانينات، وعُيِّنَ مستشارا خاصا لرئيس الوزراء أردوغان للشؤون الخارجية (2002م)ولداود أوغلو عدد من المؤلفات أهمها ثلاثة: الفلسفة السياسية، العالم الإسلامي في مهب التحولات الحضارية، العمق الاستراتيجي:
فأما كتابه "الفلسفة السياسية" فيتحدث عن التناقض الجوهري بين النظامين الإسلامي والغربي في السياسة، وكيف أن تناقض العقائد والتصور العام للوجود انعكس على النظم السياسية فأنشأت اختلافا أساسيا لا يمكن تجاوزه بين النموذجين، إذ لا يمكن التقاء العلمانية مع الإسلام، كما ويستحيل في الإسلام نشوء "قاعدة علمانية للمعرفة البشرية"وأما كتابه العالم الإسلامي في مهب التحولات الحضارية فيحمل على الفلسفة الغربية التي تنتج كل حين نظريتها عن "نهاية التاريخ" التي يتكثف فيها الغرور الغربي الذي يظن أن ما وصل إليه هو كلمة النهاية التي تطوى بعدها صحيفة التقدم الإنساني، ويذهب إلى القول بأن أزمة الفلسفة الغربية كامنة في القيم التي تعتنقها، ولهذا فلم يقدم التقدم العلمي أو الرفاه الاقتصادي العدل للبشرية ولا حتى الأمان للإنسان الغربي نفسه، كذلك فإن انهيار الاتحاد السوفيتي لا يعني نهاية التاريخ بل يعني مجرد تحول في المراكز الحضارية التي تشهد محاولات لتحول آخر من الأطلسي (كمحور الحضارة الغربية) إلى قلب أوروبا في إطار المحاولة الأوروبية للاتحاد ويبدو كذلك أن تحولا آخر يلوح في الأفق وهو المحور الآسيوي حيث الصين واليابان ودول جنوب شرق آسيا. غير أن هذا التحول نحو الشرق ليس مهما إلا بقدر ما تقدمه الفلسفة التي يطرحها هذا المحور. ثم يخلص إلى القول بأن المرشح الوحيد لإحداث تحول حضاري حقيقي هو الإسلام الذي يملك من القيم والمبادئ ما يُمَكِّنه من طرح رؤية جديدة ومنظومة مؤسسات وعلاقات قائمة على مبادئ وقيم وأخلاق مطلقة لا تملك معها أن تنشئ من المؤسسات والسياسات ما ينتهكها.
وأما كتابه "العمق الاستراتيجي" وهو أهم كتبه، والذي يعده الكثيرون أهم أدبيات حزب العدالة والتنمية، فينصب على إعادة تعريف موقع تركيا ودورها في العالم، وكيف أنها لا تملك –طبقا لنظريته في العمق الاستراتيجي- سوى أن تكون قوة عالمية بحكم موقعها الجغرافي وتاريخها العريق وثقلها الثقافي شرط أن تتصالح مع هويتها وتعيد وصل ما انقطع من العلاقات العثمانية بمجالها الحيوي الذي هو عمقها الاستراتيجي، وهو يقرر أن أي نظرية استراتيجية تكون عديمة الكفاءة إذا طرحت "تناقضات في موضوعي الهوية والوعي التاريخي باعتبارهما عامليْن أساسييْن في ضعف الاستعداد النفسي"وفيما بعد سيعمل داود أوغلو مستشارا لأردوغان ثم سفيرا ثم وزيرا للخارجية، وحينئذ سيتحول كتابه "العمق الاستراتيجي" من "أحلام أكاديمي مسلم" إلى برنامج للتطبيقنشر في تركيا بوست
بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص323. ويشبهه البعض بطه حسين في العالم العربي، لأنه مفكر وأديب ومترجم ويتقن الفرنسية، وقد أنجز هذا برغم فقدان بصره. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص298 وما بعدها؛ http://www.abdullahgul.gen.tr بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص318، 319. Rabasa, Larrabee: The Rise of Political Islam, p. 14. AK parti website: http://www.akparti.org.tr كِرِم أوكْتِم: الأمة الغاضبة ص250؛ AK parti website: http://www.akparti.org.tr أحمد داود أوغلو: الفلسفة السياسية ص17. أحمد داود أوغلو: العمق الاستراتيجي.. موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية، ترجمة: محمد جابر ثلجي وطارق عبد الجليل (الدوحة وبيروت، مركز الجزيرة للدراسات والدار العربية للعلوم ناشرون، 2011م) ص82. Rabasa, Larrabee: The Rise of Political Islam, p. 75. كِرِم أوكْتِم: الأمة الغاضبة ص255. Ömer Taspinar: Turkey’s Middle East Policies, p. 14; Aydin, Çakır: Political Islam in Turkey, p. 3. George Friedman: The Next 100 Years: A Forecast for the 21st Century, (New York, Double day, 2009), p. 144-8, 152.
Published on April 20, 2016 09:41
April 17, 2016
أثر الإيمان في انحيازات السياسة الإسلامية
قال الشيخ محمد قطب:
إن المعبودات اليوم لا تكاد تحصى! فهي أحيانا "الدولة" وأحيانا "الوطن" وأحيانا "القومية" وأحيانا "النظام" وأحيانا "الزعيم الأوحد" وأحيانا "المصلحة القومية" وأحيانا "الرأي العام" –المحلي أو العالمي- وأحيانا "الإنتاج" وأحيانا "العقل" وأحيانا "العلم" وأحيانا "التقدم" وأحيانا "الموضة".. كلها معبودات ترسم للناس مناهج حياتهم فيعمل الناس بوحيها وأمرها في الوقت الذي يعصون فيه أوامر الله، ويستكبرون عن عبادة الله!***
ليس ثمة خلاف بين المؤرخين حول أن محمدا (صلى الله عليه وسلم) فعل شيئا مذهلا في التاريخ، سواء في هذا من أحب أو من كره، وقد صرَّح العديد منهم بأنه أعظم شخصية في التاريخ، وأنه الوحيد الذي حقق نجاحا على المستوى الديني والدنيوي في الوقت نفسهوتقتضي هذه الحقيقة التاريخية، كما يقتضي واجب الاقتداء، التأمل الطويل في النموذج السياسي الذي استغرق أكثر من نصف عمره (13 سنة من 23) في التركيز على مفهوم التوحيد: لا إله إلا الله!
لا يبدو الأمر واضحا إذا فهمنا أن "التوحيد" جاء مضادا لعبادة الأصنام، بل ليس الأمر صحيحا، إنما الصحيح والواضح هو مضادة كل ما سوى الله، وإفراد الله باستحقاق العبادة، وإفراده بالحق في "وضع منهج الحياة"، فالإسلام ليس الدين الذي نزل على قريش، بل هو الدين الذي واجه عبادة فرعون وعبادة الكُهَّان والأحبار والرهبان، ومن ثمَّ فإن مواجهة أصنام قريش هي آخر فصوله.
ونعم؛ كان الطرف الآخر يفهم حقيقة الأمر هذه ويواجهها بكل عنف، وقد أعلن فرعون وحاشيته رفضهم التام لأن يكون لأي أحد غيره حق السيادة التي هي –كما يقول جان بودان- التفرد بالحقّ في إنشاء الخطاب الملزم، فقال: {قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِي} [يونس: 78]. فمعنى "الكبرياء" في الآية هو معنى "السيادة" في الاصطلاح السياسي المعاصرولذلك تمسك جميع أولئك بصنم "العادات والتقاليد، وتراث الآباء والأجداد"، قال تعالى: {وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ} [الزخرف: 23].
بعد كل هذا يكون من السذاجة الشديدة أن يُظَنَّ بأن النموذج السياسي الإسلامي يقوم حين توضع في الدستور عبارة "الإسلام دين الدولة والشريعة هي مصدر التشريع"، ولو كان الأمر كذلك لما نشب الصراع التاريخي الطويل بين الحق والباطل.
إن النموذج الذي محوره "الدولة" أو "الوطن" أو "القومية" أو "التقدم" أو "المصلحة" أو "العلم" .. إلخ، سيتناقض بطبيعته مع النموذج الذي محوره "الإسلام"، فكل هذه العناوين إما هي مرجعيات في نفسها قائمة بذاتها فيحدث التناقض في القيم العليا والثوابت والأصول والانحيازات الحضارية، وإما هي أدوات ووسائل تفتقر بطبيعتها إلى المرجعية التي تحتكم إليها (العلم مثلا ليس إلا أداة، والمرجعية الفلسفية هي التي تحدد ما هو المطلوب منها وما هو الممنوع والمحظور، وفيم يستعمل وفيم يحرم استعماله)، وإما هي معانٍ لا معنى لها بدون وجود المرجعية الحاكمة (التقدم مثلا ليس شيئا حقيقيا صلبا وإنما هو معنى تحدده المرجعية، فالتخلص من الضعفاء والمرضى هو تقدم عند نيتشه وهو إجرام عند آخرين)، ولنضرب على ذلك مثالا واحدا، يعبر عن القضية بوضوح شديد، وهو: قضية الانتماء.
يكتسب الانتماء للدولة الإسلامية بالدخول في الدين، ففي هذه اللحظة ترتب على كل من الدولة والفرد حقوق وواجبات، غير تلك التي كانت لهما وعليهما قبل تلك اللحظة، أي أنها تساوي لحظة حصول المواطن على الجنسية في الدولة الحديثة، إلا أن الدولة الحديثة تمنح جنسيتها لمن وُلِد على أرضها أو وُلِد من العِرْق الذي تنتمي له وإن كان خارج أرضها، أو بشروط معينة تضعها، ومن سوى ذلك فهو أجنبي له حقوق وواجبات مختلفة.
وهكذا يكون الانتماء للدولة الإسلامية محض قرار شخصي لا يد للدولة فيه، وهو مفتوح أمام جميع الشعوب والأعراق والألوان واللغات، ثم إن الدولة الإسلامية تحتضن بعد ذلك من لم يكن مسلما على أرضها وتضمن له بعض الحقوق والواجبات ولكنها غير تلك التي تبذلها للمسلم، بينما الانتماء للدولة الحديثة هو قرار الدولة لا قرار الفرد، وفي حين تملك الدولة الحديثة سحب الجنسية فإن الإسلام (الذي هو الجنسية في الدولة الإسلامية) لا يملك أحد أن يسحبه من المسلم.
والحقوق والواجبات التي تطلبها الدولة الإسلامية من غير المسلمين الموجودين على أراضيها هي بكل المقاييس أفضل بكثير من الحقوق والواجبات التي تطلبها الدولة الحديثة من الأجنبي المقيم على أرضها. ويمكن لأي مقارنة بين حقوق أهل الذمة (في الدولة الإسلامية) وحقوق الأجانب (في الدولة الحديثة) أن تثبت هذا بوضوح. فغير المسلم يتمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها المسلم فيما عدا إظهار ما يتعارض مع الإسلام علانية من شعارات أو معاملات ويتمتع بالدفاع عنه والأمن على حياته مقابل جزية بسيطة يبذلها القادر على الحرب، وهو أمر يشبه التزام الأجنبي بقوانين الدولة الحديثة التي يقيم بها، وهو مع ذلك لا يتمتع بنفس حقوق المواطن في التعليم والعلاج والوصول إلى الوظائف الكبرى، وهو مع ذلك أيضا يبذل من الضرائب على الدخل والنشاط ما هو أعلى مما يدفعه المواطن.
وبالمقابل، فإن الردة عن الإسلام بعد الدخول فيه إنما هو كخيانة المواطن للدولة الأجنبية في أصل أصولها وصلب شرعيتها، كالمواطن الذي يعمل على إعادة الملكية في دولة نظامها جمهوري، أو محاربة الملكية في نظام ملكي مستقر، أو تكوين -والدعوة إلى تكوين- ميليشيات مسلحة في دولة نظامها قائم على احتكار السلاح بيد السلطة، أو إعادة دولة الكنيسة في دولة تقوم على العلمانية... إلخ!
الإسلام ليس مجرد دين، بل هو نظام، وهو أمر واضح حتى للمستشرقين، يقول هاملتون جِب: "الحق أن الإسلام ليس مجرد نظام من العقائد والعبادات، إنه أعظم من ذلك كثيرا، هو مدنية كاملة، ولو بحثنا عن لفظ مقابل له لقلنا: العالم المسيحي ولم نقل المسيحية، ولقلنا الصين بدل أن نقول ديانة كونفوشيوس"لذلك تعامل الفقهاء مع حالة الردة كتعامل القانونيين والقضاة مع المهددين لنظام الدولة الحديثة، حالة الخروج على المرجعية العليا للمجتمع، وإن كان الأمر لا يزال في حاجة إلى بحوث فقهية لما استجد في هذه المسألة من نوازل معاصرة.
يمكن أن نضرب العديد من الأمثلة، إذ الإسلام ينظم المجتمع على تكتيل أفراده وتقوية المجتمع وتمتين روابطه، فيما تنحو الدولة الحديثة إلى التعامل مع المواطنين أفرادا، ولا شيء يدفع إلى هذا سوى مجمل النصوص الغزيرة التي تعظم أخوة الدين وحقوق المسلم على المسلم، وتعظم صلة الرحم وحقوق ذوي القربى، وتعظم صلة الجوار وحقوق الجيران.
وحيث يخلو نظام الدولة الحديثة (العلمانية) من نصوص مقدسة تمثل بالنسبة لها مبادئ حاكمة لا يمكن خرقها، يمنع الإسلام انتهاج سياسة تعلو فيها النفعية على المبادئ والمصلحة على الأخلاق، بل مفهوم المصلحة في الإسلام هو مفهوم محكوم بالإسلام نفسه، ولذا فهي "مصلحة شرعية" وليست مصلحة مادية مطلقة. ويحتوي الفقه الإسلامي تراثا هائلا في ضبط المصلحة الشرعية والتفريق بينها وبين المصالح الفاسدة.
ومن ألطف ما قيل في مسألة المصلحة قول المستشرق والقانوني الإيطالي دافيد دي سانتلانا في بحثه الممتع "القانون والمجتمع"، فقد أشار إلى جانب التأثير الأخلاقي للشريعة، ومن أمثلة ذلك أنه إذ كانت المطالبة بالحق واجبة؛ لأنها حق أولا، وليس لأنها منفعة شخصية فقط، فإن الجانب الأخلاقي سيُرَشِّد المطالبة بها كذلك، يقول: "ولكنه إذا كان حق المرء هو منفعته الخاصة وواجبه الأدبي معا؛ فإن لذلك الحق حدودا معينة بموجب مبادئ الأخلاق والمصلحة العامة؛ فالصلح والتراضي هما سيدا الأحكام في كل وقت، وأخذ الثأر ممنوع منعا باتا، والتضييق البدني على المدين مخالف للقانون، ولا اعتساف في استعمال الحق تماما؛ إذ ليس لأحد أن يمارس حقا له، بالدرجة التي يسبب للآخر ضررا محققا، وللفقهاء المسلمين في هذا الصدد إحساس دقيق مرهف يفوق ما نتصوره؛ فمثلا: يمنع أن يخول حق الادعاء إلى وكيل هو عدو للطرف الذي أقيمت عليه الدعوى، وممنوع أن يؤجر حيوان لشخص عرف بقسوته على الحيوان..." ثم ختم بالقول: "تلك هي الميزات التي تسم الشريعة الإسلامية في كبد حقيقتها، قد نجرؤ على وضعها في أرفع مكان، وتقليدها أجل مديح علماء القانون وهو الخليق بها... وإننا لو ضربنا صفحا عن كل ما تقدم، فلا شك وأن المستوى الأخلاقي الرفيع الذي يسم الجانب الأكبر من شريعة العرب قد عمل على تطوير وترقية مفاهيمنا العصرية، وهنا يكمن فضل هذه الشريعة الباقي على مر الدهور"نشر في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية
محمد قطب، التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية، ط1 (القاهرة: دار الشروق، 1998م)، ص67. للمزيد انظر: الإنجاز الإسلامي بعيون المؤرخين الغربيين. ذكر هذا المعنى الشيخ فوزي السعيد في شرحه لاسم الله "الكبير"، وأوقفني عليه أخي المهندس/ محمود فتحي. هاملتون أ. ر. جب وآخرون، وجهة العالم الإسلامي، ترجمة: محمد عبد الهادي أبو ريدة، (بدون بيانات)، ص9. دافيد دي سانتيلانا، القانون والمجتمع، ضمن "تراث الإسلام" بإشراف: توماس أرنولد، ترجمة: جرجيس فتح الله، ط2 (بيروت: دار الطليعة، 1972م)، ص437 – 439.
إن المعبودات اليوم لا تكاد تحصى! فهي أحيانا "الدولة" وأحيانا "الوطن" وأحيانا "القومية" وأحيانا "النظام" وأحيانا "الزعيم الأوحد" وأحيانا "المصلحة القومية" وأحيانا "الرأي العام" –المحلي أو العالمي- وأحيانا "الإنتاج" وأحيانا "العقل" وأحيانا "العلم" وأحيانا "التقدم" وأحيانا "الموضة".. كلها معبودات ترسم للناس مناهج حياتهم فيعمل الناس بوحيها وأمرها في الوقت الذي يعصون فيه أوامر الله، ويستكبرون عن عبادة الله!***
ليس ثمة خلاف بين المؤرخين حول أن محمدا (صلى الله عليه وسلم) فعل شيئا مذهلا في التاريخ، سواء في هذا من أحب أو من كره، وقد صرَّح العديد منهم بأنه أعظم شخصية في التاريخ، وأنه الوحيد الذي حقق نجاحا على المستوى الديني والدنيوي في الوقت نفسهوتقتضي هذه الحقيقة التاريخية، كما يقتضي واجب الاقتداء، التأمل الطويل في النموذج السياسي الذي استغرق أكثر من نصف عمره (13 سنة من 23) في التركيز على مفهوم التوحيد: لا إله إلا الله!
لا يبدو الأمر واضحا إذا فهمنا أن "التوحيد" جاء مضادا لعبادة الأصنام، بل ليس الأمر صحيحا، إنما الصحيح والواضح هو مضادة كل ما سوى الله، وإفراد الله باستحقاق العبادة، وإفراده بالحق في "وضع منهج الحياة"، فالإسلام ليس الدين الذي نزل على قريش، بل هو الدين الذي واجه عبادة فرعون وعبادة الكُهَّان والأحبار والرهبان، ومن ثمَّ فإن مواجهة أصنام قريش هي آخر فصوله.
ونعم؛ كان الطرف الآخر يفهم حقيقة الأمر هذه ويواجهها بكل عنف، وقد أعلن فرعون وحاشيته رفضهم التام لأن يكون لأي أحد غيره حق السيادة التي هي –كما يقول جان بودان- التفرد بالحقّ في إنشاء الخطاب الملزم، فقال: {قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِي} [يونس: 78]. فمعنى "الكبرياء" في الآية هو معنى "السيادة" في الاصطلاح السياسي المعاصرولذلك تمسك جميع أولئك بصنم "العادات والتقاليد، وتراث الآباء والأجداد"، قال تعالى: {وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ} [الزخرف: 23].
بعد كل هذا يكون من السذاجة الشديدة أن يُظَنَّ بأن النموذج السياسي الإسلامي يقوم حين توضع في الدستور عبارة "الإسلام دين الدولة والشريعة هي مصدر التشريع"، ولو كان الأمر كذلك لما نشب الصراع التاريخي الطويل بين الحق والباطل.
إن النموذج الذي محوره "الدولة" أو "الوطن" أو "القومية" أو "التقدم" أو "المصلحة" أو "العلم" .. إلخ، سيتناقض بطبيعته مع النموذج الذي محوره "الإسلام"، فكل هذه العناوين إما هي مرجعيات في نفسها قائمة بذاتها فيحدث التناقض في القيم العليا والثوابت والأصول والانحيازات الحضارية، وإما هي أدوات ووسائل تفتقر بطبيعتها إلى المرجعية التي تحتكم إليها (العلم مثلا ليس إلا أداة، والمرجعية الفلسفية هي التي تحدد ما هو المطلوب منها وما هو الممنوع والمحظور، وفيم يستعمل وفيم يحرم استعماله)، وإما هي معانٍ لا معنى لها بدون وجود المرجعية الحاكمة (التقدم مثلا ليس شيئا حقيقيا صلبا وإنما هو معنى تحدده المرجعية، فالتخلص من الضعفاء والمرضى هو تقدم عند نيتشه وهو إجرام عند آخرين)، ولنضرب على ذلك مثالا واحدا، يعبر عن القضية بوضوح شديد، وهو: قضية الانتماء.
يكتسب الانتماء للدولة الإسلامية بالدخول في الدين، ففي هذه اللحظة ترتب على كل من الدولة والفرد حقوق وواجبات، غير تلك التي كانت لهما وعليهما قبل تلك اللحظة، أي أنها تساوي لحظة حصول المواطن على الجنسية في الدولة الحديثة، إلا أن الدولة الحديثة تمنح جنسيتها لمن وُلِد على أرضها أو وُلِد من العِرْق الذي تنتمي له وإن كان خارج أرضها، أو بشروط معينة تضعها، ومن سوى ذلك فهو أجنبي له حقوق وواجبات مختلفة.
وهكذا يكون الانتماء للدولة الإسلامية محض قرار شخصي لا يد للدولة فيه، وهو مفتوح أمام جميع الشعوب والأعراق والألوان واللغات، ثم إن الدولة الإسلامية تحتضن بعد ذلك من لم يكن مسلما على أرضها وتضمن له بعض الحقوق والواجبات ولكنها غير تلك التي تبذلها للمسلم، بينما الانتماء للدولة الحديثة هو قرار الدولة لا قرار الفرد، وفي حين تملك الدولة الحديثة سحب الجنسية فإن الإسلام (الذي هو الجنسية في الدولة الإسلامية) لا يملك أحد أن يسحبه من المسلم.
والحقوق والواجبات التي تطلبها الدولة الإسلامية من غير المسلمين الموجودين على أراضيها هي بكل المقاييس أفضل بكثير من الحقوق والواجبات التي تطلبها الدولة الحديثة من الأجنبي المقيم على أرضها. ويمكن لأي مقارنة بين حقوق أهل الذمة (في الدولة الإسلامية) وحقوق الأجانب (في الدولة الحديثة) أن تثبت هذا بوضوح. فغير المسلم يتمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها المسلم فيما عدا إظهار ما يتعارض مع الإسلام علانية من شعارات أو معاملات ويتمتع بالدفاع عنه والأمن على حياته مقابل جزية بسيطة يبذلها القادر على الحرب، وهو أمر يشبه التزام الأجنبي بقوانين الدولة الحديثة التي يقيم بها، وهو مع ذلك لا يتمتع بنفس حقوق المواطن في التعليم والعلاج والوصول إلى الوظائف الكبرى، وهو مع ذلك أيضا يبذل من الضرائب على الدخل والنشاط ما هو أعلى مما يدفعه المواطن.
وبالمقابل، فإن الردة عن الإسلام بعد الدخول فيه إنما هو كخيانة المواطن للدولة الأجنبية في أصل أصولها وصلب شرعيتها، كالمواطن الذي يعمل على إعادة الملكية في دولة نظامها جمهوري، أو محاربة الملكية في نظام ملكي مستقر، أو تكوين -والدعوة إلى تكوين- ميليشيات مسلحة في دولة نظامها قائم على احتكار السلاح بيد السلطة، أو إعادة دولة الكنيسة في دولة تقوم على العلمانية... إلخ!
الإسلام ليس مجرد دين، بل هو نظام، وهو أمر واضح حتى للمستشرقين، يقول هاملتون جِب: "الحق أن الإسلام ليس مجرد نظام من العقائد والعبادات، إنه أعظم من ذلك كثيرا، هو مدنية كاملة، ولو بحثنا عن لفظ مقابل له لقلنا: العالم المسيحي ولم نقل المسيحية، ولقلنا الصين بدل أن نقول ديانة كونفوشيوس"لذلك تعامل الفقهاء مع حالة الردة كتعامل القانونيين والقضاة مع المهددين لنظام الدولة الحديثة، حالة الخروج على المرجعية العليا للمجتمع، وإن كان الأمر لا يزال في حاجة إلى بحوث فقهية لما استجد في هذه المسألة من نوازل معاصرة.
يمكن أن نضرب العديد من الأمثلة، إذ الإسلام ينظم المجتمع على تكتيل أفراده وتقوية المجتمع وتمتين روابطه، فيما تنحو الدولة الحديثة إلى التعامل مع المواطنين أفرادا، ولا شيء يدفع إلى هذا سوى مجمل النصوص الغزيرة التي تعظم أخوة الدين وحقوق المسلم على المسلم، وتعظم صلة الرحم وحقوق ذوي القربى، وتعظم صلة الجوار وحقوق الجيران.
وحيث يخلو نظام الدولة الحديثة (العلمانية) من نصوص مقدسة تمثل بالنسبة لها مبادئ حاكمة لا يمكن خرقها، يمنع الإسلام انتهاج سياسة تعلو فيها النفعية على المبادئ والمصلحة على الأخلاق، بل مفهوم المصلحة في الإسلام هو مفهوم محكوم بالإسلام نفسه، ولذا فهي "مصلحة شرعية" وليست مصلحة مادية مطلقة. ويحتوي الفقه الإسلامي تراثا هائلا في ضبط المصلحة الشرعية والتفريق بينها وبين المصالح الفاسدة.
ومن ألطف ما قيل في مسألة المصلحة قول المستشرق والقانوني الإيطالي دافيد دي سانتلانا في بحثه الممتع "القانون والمجتمع"، فقد أشار إلى جانب التأثير الأخلاقي للشريعة، ومن أمثلة ذلك أنه إذ كانت المطالبة بالحق واجبة؛ لأنها حق أولا، وليس لأنها منفعة شخصية فقط، فإن الجانب الأخلاقي سيُرَشِّد المطالبة بها كذلك، يقول: "ولكنه إذا كان حق المرء هو منفعته الخاصة وواجبه الأدبي معا؛ فإن لذلك الحق حدودا معينة بموجب مبادئ الأخلاق والمصلحة العامة؛ فالصلح والتراضي هما سيدا الأحكام في كل وقت، وأخذ الثأر ممنوع منعا باتا، والتضييق البدني على المدين مخالف للقانون، ولا اعتساف في استعمال الحق تماما؛ إذ ليس لأحد أن يمارس حقا له، بالدرجة التي يسبب للآخر ضررا محققا، وللفقهاء المسلمين في هذا الصدد إحساس دقيق مرهف يفوق ما نتصوره؛ فمثلا: يمنع أن يخول حق الادعاء إلى وكيل هو عدو للطرف الذي أقيمت عليه الدعوى، وممنوع أن يؤجر حيوان لشخص عرف بقسوته على الحيوان..." ثم ختم بالقول: "تلك هي الميزات التي تسم الشريعة الإسلامية في كبد حقيقتها، قد نجرؤ على وضعها في أرفع مكان، وتقليدها أجل مديح علماء القانون وهو الخليق بها... وإننا لو ضربنا صفحا عن كل ما تقدم، فلا شك وأن المستوى الأخلاقي الرفيع الذي يسم الجانب الأكبر من شريعة العرب قد عمل على تطوير وترقية مفاهيمنا العصرية، وهنا يكمن فضل هذه الشريعة الباقي على مر الدهور"نشر في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية
محمد قطب، التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية، ط1 (القاهرة: دار الشروق، 1998م)، ص67. للمزيد انظر: الإنجاز الإسلامي بعيون المؤرخين الغربيين. ذكر هذا المعنى الشيخ فوزي السعيد في شرحه لاسم الله "الكبير"، وأوقفني عليه أخي المهندس/ محمود فتحي. هاملتون أ. ر. جب وآخرون، وجهة العالم الإسلامي، ترجمة: محمد عبد الهادي أبو ريدة، (بدون بيانات)، ص9. دافيد دي سانتيلانا، القانون والمجتمع، ضمن "تراث الإسلام" بإشراف: توماس أرنولد، ترجمة: جرجيس فتح الله، ط2 (بيروت: دار الطليعة، 1972م)، ص437 – 439.
Published on April 17, 2016 13:34
April 15, 2016
تبسيط تاريخ مصر الحديث (2)
شارك في كتابته: د. عمرو عادل
اقرأ أولا: تبسيط تاريخ مصر الحديث (1)
(5)الاحتلال الإنجليزي
استطاع الاحتلال الإنجليزي بـ 40 ألف جندي السيطرة على شعب قوامه ستة ملايين ونصف، بينما قبل سبعين سنة استطاع 700 من أهالي رشيد إيقاف جيش إنجليزي قوامه خمسة آلاف. وتلك هي خطورة احتكار الدولة لصورة المجتمع وأساليب مقاومته.
ولم يكن غريبا أن يحاول الاحتلال كسر المجتمع لصالح الدولة، ولذا فستعود السيطرة على عناصر القوة لتكون جميعها بيد الدولة وليخلو منها المجتمع على هذا النحو:
1. ما إن تمت هزيمة عرابي وجيشه حتى كانت القوة المسلحة قد انتهت من المجتمع، وتركزت كلها بيد الدولة لفراغ المجتمع منها سابقا وهزيمة ممثله (عرابي) في جهاز الدولة (الجيش)، وقد فكك الإنجليز الجيش المصري، وصار الجيش الإنجليزي هو صاحب القوة إلى جانب فرق خاصة بالخديو تابعة بطبيعة الحال للاحتلال الإنجليزي.
2. وطارد الإنجليز القيادات الفكرية، فقد نفى الخديو جمال الدين الأفغاني منذ ما قبل الثورة العرابية، وظل عبد الله النديم مطاردا لتسع سنوات، وسجن محمد عبده بتهمة الاشتراك في الثورة العرابية، وحكم على عرابي بالإعدام ثم خفف إلى النفي خارج البلاد، وعزل شيخ الأزهر محمد الإنبابي (الذي عينته الثورة العرابية) وأُتي بمحمد العباسي المهدي، وحوكم الشيخان أحمد المنصوري وأحمد عبد الغني لاشتراكهما مع عرابي. وسيطر الإنجليز على الصحافة وبدأوا في توجيه التعليم في خطة طويلة عبر القس دنلوب الذي تولى وزارة المعارف.
3. واستسلمت المؤسسات –بطبيعة الحال- للاحتلال الإنجليزي الذي سيطر عليها، فأدار بها ثروة المجتمع المصري الذي صار تابعا تماما للمحتل، يتصرف فيه كما تقتضيه مصلحته.
4. وأنشأ الإنجليز المحاكم الأهلية التي كانت ضربة قاضية للمحاكم الشرعية، كما انتهى أمر مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب، وتعتبر أحكام محكمة دنشواي دليلا قويا على الارتباط القائم بين المؤسسات القضائية وسلطة الاحتلال.
ولا بد من القول بأن الاحتلال الإنجليزي أدار معركته مع المصريين بقدر وافر من الدهاء، وهو قدر غير مسبوق في سياسات الاحتلال الأجنبي من قبل، فلقد نفذ الإنجليز كثيرا من الإجراءات التي تبدو في ظاهرها في صالح المجتمع المصري مثل رفع العقوبات البدنية عن الفلاحين، وتخفيض الضرائب عن المعسرين، وتعيين بعض القيادات الفكرية في مواقع تبدو مؤثرة لكنها على الحقيقة ليست بذاك مثل تعيينهم للشيخ محمد عبده في منصب المفتي وإصرارهم على ذلك، ومثل عفوهم عن أحمد عرابي وإعادته من منفاه، ومثل سياستهم في النظام التعليمي التي قادها دنلوب بقدر كبير من الهدوء والكتمان من بعد ما طرد كرومر العناصر المستثارة التي حاولت تنفيذ هذه السياسات بشكل أقوى وأسرع وأعادهم إلى بريطانيا.
وبإجمال ميزان القوى داخل المجتمع في فترة الاحتلال الإنجليزي وحتى ما قبل ثورة 1919، يتبين أن قوة المجتمع قد انهارت لتصل إلى نسبة (17%) مقابل (83%) في يد سلطة الاحتلال.
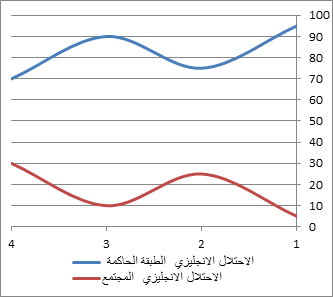
1 القوة المسلحة 2 صناعة الوعي 3 المؤسسات التنفيذية والثروة 4 التشريع والقانون
(6)ثورة 1919 ونتائجها
بعد نحو أربعين سنة من الاحتلال الإنجليزي (وهو عمر التغيير) جرى تطور نسبي في قدرات المجتمع في بعض المحاور كما حدث تراجع في محاور أخري علي النحو التالي.
1. أصبحت القوة المسلحة تابعة للاحتلال، وأصبح الجيش أحد أدوات الانجليز في حروبه ضد الأمة، كالتجريدة المصرية، واستخدام نحو مليون وربع مصري في الحرب العالمية الأولي. كما أسس الإنجليز جهاز الأمن السياسي المصري. إلا أن القوي الاجتماعية كسرت احتكار السلطة للسلاح فاستخدمت المقاومة المسلحة علي نطاق واسع مما قلل من التفاوت الكبير للقوة بين رأس السلطة والمجتمع.
2. عادت النخبة الوطنية للتشكل من جديد عقب انهيارها بعد فشل الثورة العرابية، فظهرت قيادات أمثال مصطفي كامل ومحمد فريد. وعلى الجهة الأخرى كان الإنجليز يواصلون صناعة النخبة المعبرة عنهم، وأثر هذا كله على تماسك المجتمع ووحدته ضد الاحتلال والاستبداد. وقد أدي ظهور طبقة وسطي تحمل قدرا من التعليم وظهور النقابات العمالية إلي تكوين قوي مجتمعية تستطيع منافسة رأس السلطة في صناعة الوعي وساعدت سهولة الطباعة وانتشار الإصدارات بأشكالها علي تطوير الوعي، كما قادت كوادر الحزب الوطني في تلك الفترة حملة توعية كبيرة في مصر وتعرصوا للتنكيل من الإنجليز والجهاز الأمني المصري، ما كان لشباب الأزهر وبعض شيوخه دور فاعل في بناء الوعي العام. وبذلت النخبة الاستعمارية كذلك ما استطاعت من مجهود لاستعادة السيطرة على المجتمع.
3. استغل الانجليز سيطرتهم الكاملة علي مفاصل الدولة لبناء المؤسسات لتتبعهم بصورة هيكلية ودائمة.
فصارت المؤسسات أداة ترسيخ الاحتلال واستقطاب الثروة، مما نتج عنه لا مجرد استغلال الاقتصاد بل ربطه بهم وتحويله إلى اقتصاد خادم لهم، ومنحوا الأجانب امتيازات واسعة مما أخلّ البنية المالية للمجتمع. واستمرت محاربة الأوقاف والمصادر المالية الأخري للمجتمع، إلا أن احتياج الاحتلال لطبقة وسطي فاعلة من المصريين أدي إلي وجود قدر من الثروة وخاصة في المدن لدي القوي المجتمعية.
4. الإنجاز الأكبر لثورة 1919 هو الحصول علي حق الشعب في التمثيل النيابي وتشكيل الحكومة حتي إن كانت ليست مكتملة تحت الاحتلال، إلا أن وجود مجلس نيابي أعاد بعضا من سلطة المجتمع. (وإن كان هذا المكسب هو عين فشل ثورة 19 التي كان هدفها الجلاء لا مجرد دستور ومجلس نيابي). كذلك استمرت قوي الاحتلال والطبقة الحاكمة في تغيير بنية المجتمع التشريعية حيث زادت سيطرة المحاكم الأهلية وأصبحت هي صاحبة اليد العليا علي حساب المحاكم الشرعية والعرفية.
وبإجمال ميزان القوى داخل المجتمع في فترة ثورة 1919 وما بعدها يشير إلي تحسن نسبي لقوي المجتمع، يتبين أن قوة المجتمع وصلت إلى نسبة (34%) مقابل (66%) في يد سلطة الاحتلال والطبقة الحاكمة.
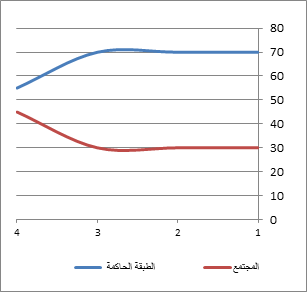
1 القوة المسلحة 2 صناعة الوعي 3 المؤسسات التنفيذية والثروة 4 التشريع والقانون
(7)قبيل انقلاب يوليو 1952
كانت مصر تغلي وعلي وشك ثورة حقيقية، وظهرت قوي مجتمعية حقيقية نازعت الطبقة الحاكمة المهترئة سلطتها بل وبدأت في شرعنة المقاومة المسلحة ضد الاحتلال مما دفع بالقوي الاستعمارية إلي استباق الحالة الثورية بالانقلاب العسكري، وفيما يلي عرض لتوازن القوي بين المجتمع ورأس السلطة قبيل انقلاب 1952.
1. لأول مرة ربما منذ المقاومة الفرنسية تتوازن القوي المسلحة بين المجتمع ورأس السلطة؛ بالرغم من أن الجيش المصري كان خارج معادلة القوي تماما وإن مال ناحية الطبقة الحاكمة ورأس السلطة والاحتلال، فلم يكن له دور في المقاومة المسلحة ضد الاحتلال، إزدادت حالة المقاومة داخل التنظيمات الشعبية وعلي رأسها جماعة الإخوان المسلمين والتيارات اليسارية ضد الاحتلال والأخطر هو شرعنة المقاومة حتي أنه طرح مشروع قانون بإباحة حمل المواطنين للسلاح. مما يعد دليلا بارزا على تصاعد إرادة المجتمع في الدفاع عن نفسه وكسر احتكار السلطة –التابعة للاحتلال- للقوي المسلحة. وعلى الجانب الآخر استقر أمر الأجهزة الأمنية والعسكرية تحت سيطرة الاحتلال فهي قد بُنيت بيده وتحت إشرافه.
2. حدثت طفرة كبري في الوعي العام عند كتل كبيرة بالمجتمع مع ظهور جماعة الإخوان المسلمين والإحياء الديني علي يد الإمام حسن البنا تلميذ الإمام محمد عبدة ومحمد رشيد رضا، وظهرت قوي يسارية قوية استطاعت تكوين قوي عمالية ومجتمعية ساعدت في استعادة المجتمع لقدرته علي الفعل.ومع انتشار الطباعة والتوسع في التعليم وامتلاك المجتمع لقواه الدعوية؛ أدي ذلك إلي إعادة التوازن مرة أخري بين المجتمع والدولة واقتراب المجتمع من تحقيق التفوق علي رأس السلطة.
3. استمرت سيطرة الاحتلال علي المؤسسات والثروة مع تحسن نسبي من استمرار تواجد الطبقة الوسطي وظهور بعض رؤوس الأموال الوطنية مما قلل من حجم احتكار الدولة للثروة عن سابق عهدها.
4. كان المجلس التشريعي –برغم ما يؤخذ عليه- أحد أدوات القوة المؤثرة علي التوازن العام بين السلطة والمجتمع، واستطاع أن يفرض حق المجتمع في إنشاء قوانينه بالرغم من البنية الفكرية غير المتوافقة مع القواعد الفكرية للمجتمع. ومن أهم مزاياه: ثبوت الحق للمجتمع في التشريع والتقنينئن ولو لم يطبق هذا بشكل حقيقي، مما أدى إلى تحسن في توازن القوي بين الاحتلال ورأس السلطة من جهة والمجتمع من جهة أخري.
والشكل الآتي يوضح توزيع القوي بين المجتمع ورأس السلطة ويظهر امتلاك المجتمع ل 42.5% من إجمالي أدوات القوة مقابل 57.5% لرأس السلطة.
وبهذا وصل المجتمع إلي نقطة حرجة جديدة واقترب من انتزاع السلطة من الاحتلال وطبقته الحاكمة.
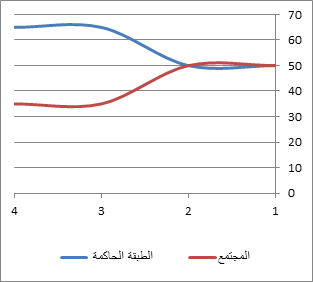
1 القوة المسلحة 2 صناعة الوعي 3 المؤسسات التنفيذية والثروة 4 التشريع والقانون
(8)حقبة العسكر
هي بامتياز أسوأ مرحلة في تاريخ مصر، دُمِّرفيها المجتمع وكل قواه بشكل ممنهج؛ واستطاعت رأس السلطة تكوين طبقة حاكمة نموذجية وأبعدت الشعب بشكل شبه كامل عن السلطة. وفيما يلي عرض نتائج حقبة العسكر علي مصر
1. احتكرت الطبقة الحاكمة تماما القوة المسلحة سواءا في شكلها الأمني أو العسكري أو حتي القوي "المدنية" التي استعان بها. والأخطر هو تكون صورة ذهنية حتي عند القوي الفاعلة في المجتمع بأن ذلك هو الحق المبين واستسلامها الكامل لهذا الاحتكار الذي أدي إلي تدجين الكثير من القوي المجتمعية. وتحولت كل مؤسسات القوة إلي مؤسسات قهر للشعب.
2. احتكرت الطبقة الحاكمة العسكرية صناعة الوعي وسيطرت علي المؤسسات الرئيسية لصناعته؛ الثقافة الإعلام والتعليم؛ وسيطرت علي الأزهر تماما وأذابته وقضت علي البقية الباقية منه وتم احتلاله من رأسه وإفساد منظومة التعليم وبه واستخدمته لصناعة وترويج أفكارها عن السلطة وعن الإسلام. كما دمرت بنية التعليم في كل مستوياته في مصر ووصلت تقييم التعليم العالي والتعليم الأساسي إلي مستويات شديدة التدني. وانتزعت الدولة أي شكل من أشكال التعليم من المجتمع فشوهت فكرة لتعليم ما قبل المدرسي "الكتاتيب" وأنهت تماما علي فكرة الأوقاف؛ وكان إلغاء الأوقاف الخيرية أحد أول قرارات الانقلاب العسكري عام 1952 مما أضعف من قدرات المجتمع علي المشاركة في ملف التعليم. وعلي صعيد المؤسسات الدعوية؛ لم تسمح إلا للمؤسسات التي تتوافق مع سياستها ورؤيتها وحاربت بكل عنف أي مؤسسة دعوية بأذرعها الأمنية والعسكرية مما أدي إلي تراجع كبير لدور المجتمع في صناعة الوعي مع شبه احتكار من رأس السلطة العسكرية لذلك، وأدي هذا الاحتكار إلي تشويه شديد في العقل الجمعي للمجتمع وضح أثره في أحداث ما بعد بداية ثورة يناير.
3. وعلي مستوي المؤسسات التنفيذية قامت باحتكار السلطة بها لصالح رجال الطبقة الحاكمة وسيطرت إلي حد كبير علي كافة مفاصلها؛ كما سيطرت علي الثروة في صالح مجموعة موالية لها مما أدي إلي إفقار شديد بالشعب المصري، وأثر إلغاء فكرة الأوقاف من المجتمع إلي زيادة معدلات الفقر وامتلاك رأس السلطة الحاكمة لمعظم السلطة والثروة.
4. انتهت فكرة تمثيل الشعب في مجلس نيابي وأصبح المجلس النيابي هو هيئة معاونة للسلطة التنفيذية؛ فقد ألغت سلطة العسكر تقريبا فكرة المجلس النيابي بل واستخدمته كوسيلة للاستبداد في كثير من الأحيان؛ وألغت طبقة العسكر المحاكم الشرعية تماما فور حدوث انقلاب 52 وأصبح نموذج المحاكم الأهلية هو المسيطر علي ساحات القضاء وتعمدت تدمير بنية القضاء باختيار أسوأ العناصر بالمجتمع في هذه المؤسسة وتحولت في نهاية الأمر إلي سلطة تابعة للسلطة التنفيذية.
تحولت مصر في أواسط العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلي حالة من الاحتكار الكامل للسلطة من الطبقة الحاكمة والشكل التالي يعبر عن توزيع أدوات القوة بين المجتمع ورأس السلطة ويظهر تفوق كاسح لرأس السلطة عن المجتمع حيث امتلكت الدولة 84% من أدوات القوة في مقابل 16% للمجتمع وهي أدني نسبة خلال المائتي عام الأخيرة
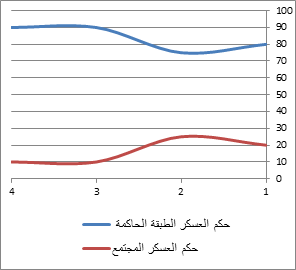
1 القوة المسلحة 2 صناعة الوعي 3 المؤسسات التنفيذية والثروة 4 التشريع والقانون في المقال القادم –بإذن الله تعالى- نتحدث عن ثورة يناير وما بعدها، وعن خلاصة هذا التاريخ، وتوصيات الدراسة.
نشر في ساسة بوست
اقرأ أولا: تبسيط تاريخ مصر الحديث (1)
(5)الاحتلال الإنجليزي
استطاع الاحتلال الإنجليزي بـ 40 ألف جندي السيطرة على شعب قوامه ستة ملايين ونصف، بينما قبل سبعين سنة استطاع 700 من أهالي رشيد إيقاف جيش إنجليزي قوامه خمسة آلاف. وتلك هي خطورة احتكار الدولة لصورة المجتمع وأساليب مقاومته.
ولم يكن غريبا أن يحاول الاحتلال كسر المجتمع لصالح الدولة، ولذا فستعود السيطرة على عناصر القوة لتكون جميعها بيد الدولة وليخلو منها المجتمع على هذا النحو:
1. ما إن تمت هزيمة عرابي وجيشه حتى كانت القوة المسلحة قد انتهت من المجتمع، وتركزت كلها بيد الدولة لفراغ المجتمع منها سابقا وهزيمة ممثله (عرابي) في جهاز الدولة (الجيش)، وقد فكك الإنجليز الجيش المصري، وصار الجيش الإنجليزي هو صاحب القوة إلى جانب فرق خاصة بالخديو تابعة بطبيعة الحال للاحتلال الإنجليزي.
2. وطارد الإنجليز القيادات الفكرية، فقد نفى الخديو جمال الدين الأفغاني منذ ما قبل الثورة العرابية، وظل عبد الله النديم مطاردا لتسع سنوات، وسجن محمد عبده بتهمة الاشتراك في الثورة العرابية، وحكم على عرابي بالإعدام ثم خفف إلى النفي خارج البلاد، وعزل شيخ الأزهر محمد الإنبابي (الذي عينته الثورة العرابية) وأُتي بمحمد العباسي المهدي، وحوكم الشيخان أحمد المنصوري وأحمد عبد الغني لاشتراكهما مع عرابي. وسيطر الإنجليز على الصحافة وبدأوا في توجيه التعليم في خطة طويلة عبر القس دنلوب الذي تولى وزارة المعارف.
3. واستسلمت المؤسسات –بطبيعة الحال- للاحتلال الإنجليزي الذي سيطر عليها، فأدار بها ثروة المجتمع المصري الذي صار تابعا تماما للمحتل، يتصرف فيه كما تقتضيه مصلحته.
4. وأنشأ الإنجليز المحاكم الأهلية التي كانت ضربة قاضية للمحاكم الشرعية، كما انتهى أمر مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب، وتعتبر أحكام محكمة دنشواي دليلا قويا على الارتباط القائم بين المؤسسات القضائية وسلطة الاحتلال.
ولا بد من القول بأن الاحتلال الإنجليزي أدار معركته مع المصريين بقدر وافر من الدهاء، وهو قدر غير مسبوق في سياسات الاحتلال الأجنبي من قبل، فلقد نفذ الإنجليز كثيرا من الإجراءات التي تبدو في ظاهرها في صالح المجتمع المصري مثل رفع العقوبات البدنية عن الفلاحين، وتخفيض الضرائب عن المعسرين، وتعيين بعض القيادات الفكرية في مواقع تبدو مؤثرة لكنها على الحقيقة ليست بذاك مثل تعيينهم للشيخ محمد عبده في منصب المفتي وإصرارهم على ذلك، ومثل عفوهم عن أحمد عرابي وإعادته من منفاه، ومثل سياستهم في النظام التعليمي التي قادها دنلوب بقدر كبير من الهدوء والكتمان من بعد ما طرد كرومر العناصر المستثارة التي حاولت تنفيذ هذه السياسات بشكل أقوى وأسرع وأعادهم إلى بريطانيا.
وبإجمال ميزان القوى داخل المجتمع في فترة الاحتلال الإنجليزي وحتى ما قبل ثورة 1919، يتبين أن قوة المجتمع قد انهارت لتصل إلى نسبة (17%) مقابل (83%) في يد سلطة الاحتلال.
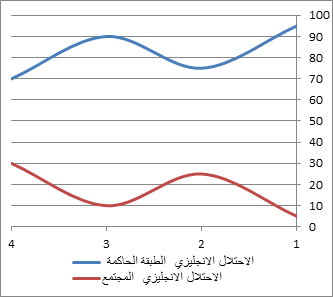
1 القوة المسلحة 2 صناعة الوعي 3 المؤسسات التنفيذية والثروة 4 التشريع والقانون
(6)ثورة 1919 ونتائجها
بعد نحو أربعين سنة من الاحتلال الإنجليزي (وهو عمر التغيير) جرى تطور نسبي في قدرات المجتمع في بعض المحاور كما حدث تراجع في محاور أخري علي النحو التالي.
1. أصبحت القوة المسلحة تابعة للاحتلال، وأصبح الجيش أحد أدوات الانجليز في حروبه ضد الأمة، كالتجريدة المصرية، واستخدام نحو مليون وربع مصري في الحرب العالمية الأولي. كما أسس الإنجليز جهاز الأمن السياسي المصري. إلا أن القوي الاجتماعية كسرت احتكار السلطة للسلاح فاستخدمت المقاومة المسلحة علي نطاق واسع مما قلل من التفاوت الكبير للقوة بين رأس السلطة والمجتمع.
2. عادت النخبة الوطنية للتشكل من جديد عقب انهيارها بعد فشل الثورة العرابية، فظهرت قيادات أمثال مصطفي كامل ومحمد فريد. وعلى الجهة الأخرى كان الإنجليز يواصلون صناعة النخبة المعبرة عنهم، وأثر هذا كله على تماسك المجتمع ووحدته ضد الاحتلال والاستبداد. وقد أدي ظهور طبقة وسطي تحمل قدرا من التعليم وظهور النقابات العمالية إلي تكوين قوي مجتمعية تستطيع منافسة رأس السلطة في صناعة الوعي وساعدت سهولة الطباعة وانتشار الإصدارات بأشكالها علي تطوير الوعي، كما قادت كوادر الحزب الوطني في تلك الفترة حملة توعية كبيرة في مصر وتعرصوا للتنكيل من الإنجليز والجهاز الأمني المصري، ما كان لشباب الأزهر وبعض شيوخه دور فاعل في بناء الوعي العام. وبذلت النخبة الاستعمارية كذلك ما استطاعت من مجهود لاستعادة السيطرة على المجتمع.
3. استغل الانجليز سيطرتهم الكاملة علي مفاصل الدولة لبناء المؤسسات لتتبعهم بصورة هيكلية ودائمة.
فصارت المؤسسات أداة ترسيخ الاحتلال واستقطاب الثروة، مما نتج عنه لا مجرد استغلال الاقتصاد بل ربطه بهم وتحويله إلى اقتصاد خادم لهم، ومنحوا الأجانب امتيازات واسعة مما أخلّ البنية المالية للمجتمع. واستمرت محاربة الأوقاف والمصادر المالية الأخري للمجتمع، إلا أن احتياج الاحتلال لطبقة وسطي فاعلة من المصريين أدي إلي وجود قدر من الثروة وخاصة في المدن لدي القوي المجتمعية.
4. الإنجاز الأكبر لثورة 1919 هو الحصول علي حق الشعب في التمثيل النيابي وتشكيل الحكومة حتي إن كانت ليست مكتملة تحت الاحتلال، إلا أن وجود مجلس نيابي أعاد بعضا من سلطة المجتمع. (وإن كان هذا المكسب هو عين فشل ثورة 19 التي كان هدفها الجلاء لا مجرد دستور ومجلس نيابي). كذلك استمرت قوي الاحتلال والطبقة الحاكمة في تغيير بنية المجتمع التشريعية حيث زادت سيطرة المحاكم الأهلية وأصبحت هي صاحبة اليد العليا علي حساب المحاكم الشرعية والعرفية.
وبإجمال ميزان القوى داخل المجتمع في فترة ثورة 1919 وما بعدها يشير إلي تحسن نسبي لقوي المجتمع، يتبين أن قوة المجتمع وصلت إلى نسبة (34%) مقابل (66%) في يد سلطة الاحتلال والطبقة الحاكمة.
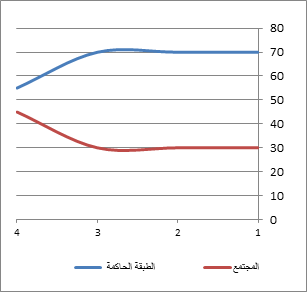
1 القوة المسلحة 2 صناعة الوعي 3 المؤسسات التنفيذية والثروة 4 التشريع والقانون
(7)قبيل انقلاب يوليو 1952
كانت مصر تغلي وعلي وشك ثورة حقيقية، وظهرت قوي مجتمعية حقيقية نازعت الطبقة الحاكمة المهترئة سلطتها بل وبدأت في شرعنة المقاومة المسلحة ضد الاحتلال مما دفع بالقوي الاستعمارية إلي استباق الحالة الثورية بالانقلاب العسكري، وفيما يلي عرض لتوازن القوي بين المجتمع ورأس السلطة قبيل انقلاب 1952.
1. لأول مرة ربما منذ المقاومة الفرنسية تتوازن القوي المسلحة بين المجتمع ورأس السلطة؛ بالرغم من أن الجيش المصري كان خارج معادلة القوي تماما وإن مال ناحية الطبقة الحاكمة ورأس السلطة والاحتلال، فلم يكن له دور في المقاومة المسلحة ضد الاحتلال، إزدادت حالة المقاومة داخل التنظيمات الشعبية وعلي رأسها جماعة الإخوان المسلمين والتيارات اليسارية ضد الاحتلال والأخطر هو شرعنة المقاومة حتي أنه طرح مشروع قانون بإباحة حمل المواطنين للسلاح. مما يعد دليلا بارزا على تصاعد إرادة المجتمع في الدفاع عن نفسه وكسر احتكار السلطة –التابعة للاحتلال- للقوي المسلحة. وعلى الجانب الآخر استقر أمر الأجهزة الأمنية والعسكرية تحت سيطرة الاحتلال فهي قد بُنيت بيده وتحت إشرافه.
2. حدثت طفرة كبري في الوعي العام عند كتل كبيرة بالمجتمع مع ظهور جماعة الإخوان المسلمين والإحياء الديني علي يد الإمام حسن البنا تلميذ الإمام محمد عبدة ومحمد رشيد رضا، وظهرت قوي يسارية قوية استطاعت تكوين قوي عمالية ومجتمعية ساعدت في استعادة المجتمع لقدرته علي الفعل.ومع انتشار الطباعة والتوسع في التعليم وامتلاك المجتمع لقواه الدعوية؛ أدي ذلك إلي إعادة التوازن مرة أخري بين المجتمع والدولة واقتراب المجتمع من تحقيق التفوق علي رأس السلطة.
3. استمرت سيطرة الاحتلال علي المؤسسات والثروة مع تحسن نسبي من استمرار تواجد الطبقة الوسطي وظهور بعض رؤوس الأموال الوطنية مما قلل من حجم احتكار الدولة للثروة عن سابق عهدها.
4. كان المجلس التشريعي –برغم ما يؤخذ عليه- أحد أدوات القوة المؤثرة علي التوازن العام بين السلطة والمجتمع، واستطاع أن يفرض حق المجتمع في إنشاء قوانينه بالرغم من البنية الفكرية غير المتوافقة مع القواعد الفكرية للمجتمع. ومن أهم مزاياه: ثبوت الحق للمجتمع في التشريع والتقنينئن ولو لم يطبق هذا بشكل حقيقي، مما أدى إلى تحسن في توازن القوي بين الاحتلال ورأس السلطة من جهة والمجتمع من جهة أخري.
والشكل الآتي يوضح توزيع القوي بين المجتمع ورأس السلطة ويظهر امتلاك المجتمع ل 42.5% من إجمالي أدوات القوة مقابل 57.5% لرأس السلطة.
وبهذا وصل المجتمع إلي نقطة حرجة جديدة واقترب من انتزاع السلطة من الاحتلال وطبقته الحاكمة.
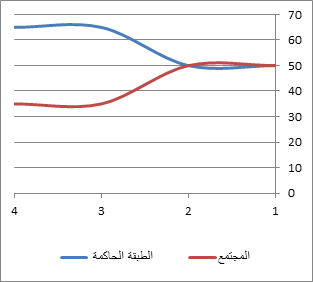
1 القوة المسلحة 2 صناعة الوعي 3 المؤسسات التنفيذية والثروة 4 التشريع والقانون
(8)حقبة العسكر
هي بامتياز أسوأ مرحلة في تاريخ مصر، دُمِّرفيها المجتمع وكل قواه بشكل ممنهج؛ واستطاعت رأس السلطة تكوين طبقة حاكمة نموذجية وأبعدت الشعب بشكل شبه كامل عن السلطة. وفيما يلي عرض نتائج حقبة العسكر علي مصر
1. احتكرت الطبقة الحاكمة تماما القوة المسلحة سواءا في شكلها الأمني أو العسكري أو حتي القوي "المدنية" التي استعان بها. والأخطر هو تكون صورة ذهنية حتي عند القوي الفاعلة في المجتمع بأن ذلك هو الحق المبين واستسلامها الكامل لهذا الاحتكار الذي أدي إلي تدجين الكثير من القوي المجتمعية. وتحولت كل مؤسسات القوة إلي مؤسسات قهر للشعب.
2. احتكرت الطبقة الحاكمة العسكرية صناعة الوعي وسيطرت علي المؤسسات الرئيسية لصناعته؛ الثقافة الإعلام والتعليم؛ وسيطرت علي الأزهر تماما وأذابته وقضت علي البقية الباقية منه وتم احتلاله من رأسه وإفساد منظومة التعليم وبه واستخدمته لصناعة وترويج أفكارها عن السلطة وعن الإسلام. كما دمرت بنية التعليم في كل مستوياته في مصر ووصلت تقييم التعليم العالي والتعليم الأساسي إلي مستويات شديدة التدني. وانتزعت الدولة أي شكل من أشكال التعليم من المجتمع فشوهت فكرة لتعليم ما قبل المدرسي "الكتاتيب" وأنهت تماما علي فكرة الأوقاف؛ وكان إلغاء الأوقاف الخيرية أحد أول قرارات الانقلاب العسكري عام 1952 مما أضعف من قدرات المجتمع علي المشاركة في ملف التعليم. وعلي صعيد المؤسسات الدعوية؛ لم تسمح إلا للمؤسسات التي تتوافق مع سياستها ورؤيتها وحاربت بكل عنف أي مؤسسة دعوية بأذرعها الأمنية والعسكرية مما أدي إلي تراجع كبير لدور المجتمع في صناعة الوعي مع شبه احتكار من رأس السلطة العسكرية لذلك، وأدي هذا الاحتكار إلي تشويه شديد في العقل الجمعي للمجتمع وضح أثره في أحداث ما بعد بداية ثورة يناير.
3. وعلي مستوي المؤسسات التنفيذية قامت باحتكار السلطة بها لصالح رجال الطبقة الحاكمة وسيطرت إلي حد كبير علي كافة مفاصلها؛ كما سيطرت علي الثروة في صالح مجموعة موالية لها مما أدي إلي إفقار شديد بالشعب المصري، وأثر إلغاء فكرة الأوقاف من المجتمع إلي زيادة معدلات الفقر وامتلاك رأس السلطة الحاكمة لمعظم السلطة والثروة.
4. انتهت فكرة تمثيل الشعب في مجلس نيابي وأصبح المجلس النيابي هو هيئة معاونة للسلطة التنفيذية؛ فقد ألغت سلطة العسكر تقريبا فكرة المجلس النيابي بل واستخدمته كوسيلة للاستبداد في كثير من الأحيان؛ وألغت طبقة العسكر المحاكم الشرعية تماما فور حدوث انقلاب 52 وأصبح نموذج المحاكم الأهلية هو المسيطر علي ساحات القضاء وتعمدت تدمير بنية القضاء باختيار أسوأ العناصر بالمجتمع في هذه المؤسسة وتحولت في نهاية الأمر إلي سلطة تابعة للسلطة التنفيذية.
تحولت مصر في أواسط العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلي حالة من الاحتكار الكامل للسلطة من الطبقة الحاكمة والشكل التالي يعبر عن توزيع أدوات القوة بين المجتمع ورأس السلطة ويظهر تفوق كاسح لرأس السلطة عن المجتمع حيث امتلكت الدولة 84% من أدوات القوة في مقابل 16% للمجتمع وهي أدني نسبة خلال المائتي عام الأخيرة
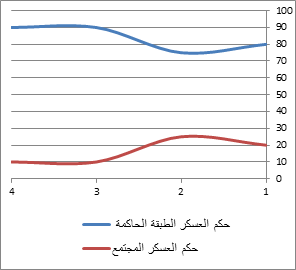
1 القوة المسلحة 2 صناعة الوعي 3 المؤسسات التنفيذية والثروة 4 التشريع والقانون في المقال القادم –بإذن الله تعالى- نتحدث عن ثورة يناير وما بعدها، وعن خلاصة هذا التاريخ، وتوصيات الدراسة.
نشر في ساسة بوست
Published on April 15, 2016 21:31
April 12, 2016
قصة الخلاف بين أربكان وأردوغان
اقرأ أولا: · موجز تجربة نجم الدين أربكان (جـ1، جـ2، جـ3)· موجز قصة أردوغان
بدأ ظهور الخلاف بين أردوغان وأربكان في ذات اللحظة التي بدأ فيها بروز أردوغان، وحرصه على إدارة شعبة الحزب في اسطنبول بطريقة تخالف طريقة أربكان، ويبدو في الأفق مرحلتيْن متمايزتيْن في هذا الخلاف؛ الأولى: كانت قيادة أربكان تنتصر ويبتلع أردوغان غضبه ورفضه، والثانية: كانت إرادة أردوغان تصر على مواقفها وتحسم الأمور لصالحها فيما بدا وكأنه استقلال فعلي عن قيادة الحزب، وإن حرص كلا الطرفين على نفي وجودها، وكان يدعم أردوغان في هذا نجاحاته التي يحققها في شعبة اسطنبول وفي إدارة بلدية اسطنبول الكبرى مما يجعله ذا وزن ثقيل لدى أعضاء الحزب وجمهوره ويجعل التفريط فيه مسألة في غاية الصعوبة.
مع استبعاد تفاصيل جزئية صغيرة وقديمةيرى البعض أن سببا رئيسيا في توتر الأزمة هو كون أردوغان يمثل زعيما بديلا لأربكان، وهو ما يتبدى في قوة شخصيته واستقلاليته وابتكاره لأساليب جديدة وتحقيقه نجاحات مضطردة، لا سيما وأن أردوغان لم يكن في وقت ما مدعوما من قبل المركز العام كاختيار بل كان يخوض الانتخابات الداخلية في العادة ضد من يحظون برغبة المركز العام ثم يفوزونستطيع القول بأن أردوغان بفوزه برئاسة بلدية اسطنبول الكبرى قد صار الرجل الثاني في الحزب –عمليا، وشعبيا- بعد أربكان، وما كان لسفينة يقودها اثنان مختلفان إلى هذا الحد أن تستمر كما هي. إلا أن الضربة الفارقة جاءتهم من خارجهم: ذلك هو الانقلاب العسكري الناعم (1997م) والذي قَلَبَ –مِن بين ما قَلَبَ- أوراقَ حزب الرفاه، ووضعها أمام اختبار جديد.
لقد حُلَّ حزب الرفاه وحوكم أربكان وأردوغان وحُظِر عليهما ممارسة السياسة، إلا أن الحكم على أردوغان بالسجن ضاعف بشكل هائل من تعاطف الجماهير معه، فهو المسجون ظلما لبيتي شعر يدرسان في المناهج بعد عطاء ونجاح غير مسبوق في اسطنبول بُعيْد انقلاب عسكري على حكومة إسلامية، ونستطيع أن نقول: إن هذه اللحظة كانت إضافة كبرى لرصيد أردوغان الشعبي وحجر زاوية في تأسيس زعامته التي سيرث بها أستاذه أربكان!
وفي سياق آخر كشفت ضربة الانقلاب عن تيار معارض داخل الحزب، وبرز هذا التيار عندما تشكل حزب الفضيلة ليرث حزب الرفاه، فظهرت لأول مرة مجموعة تريد إجراء انتخابات داخلية حقيقية ولا تنصاع لرغبة الزعيم نجم الدين أربكان التي كانت تدعم أن يتولى رئاسة الحزب رجائي طوقان الذي يصفه أردوغان بأنه "شخص تابع ينفذ ما يأمره به أكثر من شخص ينمّي الكيان الجديد ويطوره" بل ويقول بأن الاستطلاعات والمشاورات التي جرت في حزب الرفاه قُبيْل إغلاقه كانت ترشح أردوغان ليخلف أربكان -في حالة حظره من ممارسة السياسية- بنسبة 85%، وقد كان فريق "التجديديين" -كالعادة في مثل تلك المواقف- يملك الكوادر والحماسة ولا يملك المال ولا النفوذ! وحيث كان أردوغان نفسه محظورا من العمل السياسي، فإن فريق التجديد هذا اختار عبد الله غُل –رفيق أردوغان- ليرشحه رئيسا للحزب أمام رجائي قوطان (مرشح أربكان)، ويعترف غُل بأن الأمر كان عسيرا؛ إذ سيتعرضون لتهم الخيانة وشق الصف وإشعال الفتنكانت تلك هي لحظة الانفصال الحقيقي، وقد صرح عدد من فريق أربكان بأن أولئك الشباب إن نجحوا فسيؤسس الأستاذ حزبا جديدا وسينسحبون معه إلى الحزب الجديد، وهكذا صار واضحا أن الفريقين لن يجتمعا. كانت هذه المنافسة العلنية "سابقة في تاريخ الأحزاب الإسلامية التركية"يقول أردوغان: "لو لم يغلق حزب الفضيلة لما كنَّا قد انفصلنا بسهولة أبدا"، ولكنه لما قيل له بعد فترة: أنت تتكلم مثل أربكان تماما، قال: "لو كنا نتحدث من نفس المنطق لكان معي هنا الآن"نشر في تركيا بوست
منها: أن أردوغان وهو في الرابعة والعشرين من عمره كان من ضمن المعترضين على أسلوب إدارة حزب السلامة الوطني بعد تراجعه في انتخابات البرلمان 1977 عن نتائجه في 1973 (من 11.8% = 48 مقعدا إلى 8.5% = 24 مقعدا)، وقد تقدم المعترضون بقائمة انتخابية عام 1987 في مؤتمر الحزب الرابع ضد قائمة أربكان، إلا أنهم خسروا. ومنها أن أربكان كان يرشحه في مناطق ليس للحزب فيها فرصة للفوز. ومنها: إصرار الحزب على وضع لجنة شرعية تقيم أساليب أردوغان في انتخابات محليات باي أوغلو التي أراد خوضها منفردا ليجرب أساليبه المخالفة لعموم تقاليد حزب الرفاه.انظر: بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص55، 56، 58، 60. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص90 وما بعدها. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص99 وما بعدها. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص115. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص120، 121. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص125. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص138 وما بعدها. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص121، 122. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص108 وما بعدها، 127، 128، 136، 137. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص56، 136. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص45، 153، 154، 157، 158؛ Cemal Karakas: Turkey, Islam and Laicism, p. 28. عبد الله جُل لبرنامج تحت المجهر: "العثمانيون الجدد"، قناة الجزيرة، بتاريخ 26 يوليو 2007 Rabasa, Larrabee: The Rise of Political Islam, p. 44-5. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص289، 296، 297. Hale, Özbudun: Islamism, Democracy, and Liberalism, p. 5. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص301 وما بعدها. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص319، 394.
بدأ ظهور الخلاف بين أردوغان وأربكان في ذات اللحظة التي بدأ فيها بروز أردوغان، وحرصه على إدارة شعبة الحزب في اسطنبول بطريقة تخالف طريقة أربكان، ويبدو في الأفق مرحلتيْن متمايزتيْن في هذا الخلاف؛ الأولى: كانت قيادة أربكان تنتصر ويبتلع أردوغان غضبه ورفضه، والثانية: كانت إرادة أردوغان تصر على مواقفها وتحسم الأمور لصالحها فيما بدا وكأنه استقلال فعلي عن قيادة الحزب، وإن حرص كلا الطرفين على نفي وجودها، وكان يدعم أردوغان في هذا نجاحاته التي يحققها في شعبة اسطنبول وفي إدارة بلدية اسطنبول الكبرى مما يجعله ذا وزن ثقيل لدى أعضاء الحزب وجمهوره ويجعل التفريط فيه مسألة في غاية الصعوبة.
مع استبعاد تفاصيل جزئية صغيرة وقديمةيرى البعض أن سببا رئيسيا في توتر الأزمة هو كون أردوغان يمثل زعيما بديلا لأربكان، وهو ما يتبدى في قوة شخصيته واستقلاليته وابتكاره لأساليب جديدة وتحقيقه نجاحات مضطردة، لا سيما وأن أردوغان لم يكن في وقت ما مدعوما من قبل المركز العام كاختيار بل كان يخوض الانتخابات الداخلية في العادة ضد من يحظون برغبة المركز العام ثم يفوزونستطيع القول بأن أردوغان بفوزه برئاسة بلدية اسطنبول الكبرى قد صار الرجل الثاني في الحزب –عمليا، وشعبيا- بعد أربكان، وما كان لسفينة يقودها اثنان مختلفان إلى هذا الحد أن تستمر كما هي. إلا أن الضربة الفارقة جاءتهم من خارجهم: ذلك هو الانقلاب العسكري الناعم (1997م) والذي قَلَبَ –مِن بين ما قَلَبَ- أوراقَ حزب الرفاه، ووضعها أمام اختبار جديد.
لقد حُلَّ حزب الرفاه وحوكم أربكان وأردوغان وحُظِر عليهما ممارسة السياسة، إلا أن الحكم على أردوغان بالسجن ضاعف بشكل هائل من تعاطف الجماهير معه، فهو المسجون ظلما لبيتي شعر يدرسان في المناهج بعد عطاء ونجاح غير مسبوق في اسطنبول بُعيْد انقلاب عسكري على حكومة إسلامية، ونستطيع أن نقول: إن هذه اللحظة كانت إضافة كبرى لرصيد أردوغان الشعبي وحجر زاوية في تأسيس زعامته التي سيرث بها أستاذه أربكان!
وفي سياق آخر كشفت ضربة الانقلاب عن تيار معارض داخل الحزب، وبرز هذا التيار عندما تشكل حزب الفضيلة ليرث حزب الرفاه، فظهرت لأول مرة مجموعة تريد إجراء انتخابات داخلية حقيقية ولا تنصاع لرغبة الزعيم نجم الدين أربكان التي كانت تدعم أن يتولى رئاسة الحزب رجائي طوقان الذي يصفه أردوغان بأنه "شخص تابع ينفذ ما يأمره به أكثر من شخص ينمّي الكيان الجديد ويطوره" بل ويقول بأن الاستطلاعات والمشاورات التي جرت في حزب الرفاه قُبيْل إغلاقه كانت ترشح أردوغان ليخلف أربكان -في حالة حظره من ممارسة السياسية- بنسبة 85%، وقد كان فريق "التجديديين" -كالعادة في مثل تلك المواقف- يملك الكوادر والحماسة ولا يملك المال ولا النفوذ! وحيث كان أردوغان نفسه محظورا من العمل السياسي، فإن فريق التجديد هذا اختار عبد الله غُل –رفيق أردوغان- ليرشحه رئيسا للحزب أمام رجائي قوطان (مرشح أربكان)، ويعترف غُل بأن الأمر كان عسيرا؛ إذ سيتعرضون لتهم الخيانة وشق الصف وإشعال الفتنكانت تلك هي لحظة الانفصال الحقيقي، وقد صرح عدد من فريق أربكان بأن أولئك الشباب إن نجحوا فسيؤسس الأستاذ حزبا جديدا وسينسحبون معه إلى الحزب الجديد، وهكذا صار واضحا أن الفريقين لن يجتمعا. كانت هذه المنافسة العلنية "سابقة في تاريخ الأحزاب الإسلامية التركية"يقول أردوغان: "لو لم يغلق حزب الفضيلة لما كنَّا قد انفصلنا بسهولة أبدا"، ولكنه لما قيل له بعد فترة: أنت تتكلم مثل أربكان تماما، قال: "لو كنا نتحدث من نفس المنطق لكان معي هنا الآن"نشر في تركيا بوست
منها: أن أردوغان وهو في الرابعة والعشرين من عمره كان من ضمن المعترضين على أسلوب إدارة حزب السلامة الوطني بعد تراجعه في انتخابات البرلمان 1977 عن نتائجه في 1973 (من 11.8% = 48 مقعدا إلى 8.5% = 24 مقعدا)، وقد تقدم المعترضون بقائمة انتخابية عام 1987 في مؤتمر الحزب الرابع ضد قائمة أربكان، إلا أنهم خسروا. ومنها أن أربكان كان يرشحه في مناطق ليس للحزب فيها فرصة للفوز. ومنها: إصرار الحزب على وضع لجنة شرعية تقيم أساليب أردوغان في انتخابات محليات باي أوغلو التي أراد خوضها منفردا ليجرب أساليبه المخالفة لعموم تقاليد حزب الرفاه.انظر: بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص55، 56، 58، 60. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص90 وما بعدها. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص99 وما بعدها. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص115. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص120، 121. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص125. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص138 وما بعدها. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص121، 122. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص108 وما بعدها، 127، 128، 136، 137. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص56، 136. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص45، 153، 154، 157، 158؛ Cemal Karakas: Turkey, Islam and Laicism, p. 28. عبد الله جُل لبرنامج تحت المجهر: "العثمانيون الجدد"، قناة الجزيرة، بتاريخ 26 يوليو 2007 Rabasa, Larrabee: The Rise of Political Islam, p. 44-5. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص289، 296، 297. Hale, Özbudun: Islamism, Democracy, and Liberalism, p. 5. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص301 وما بعدها. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص319، 394.
Published on April 12, 2016 06:43
April 9, 2016
المشكلة الأخلاقية في الحضارة الإسلامية
نواصل في هذا المقال ما كنا افتتحناه في المقالين السابقين: شرعية السلطة بين الإسلام والعلمانية، قيمة ومعنى وجود نموذج سياسي إسلامي. والغرض من هذه المقالات هو توضيح أن النموذج السياسي الإسلامي هو نموذج متفرد ومتميز عن سائر النماذج السياسية، وأن تميزه هذا راجع إلى أمرين:
الأول: وجود النص المعصوم من القرآن والسنة والذي لا يستطيع حاكم إلغاءه أو تغييره أو إسقاطه، حتى إن حاول تأويله أو حمله على وجه باطل كان أمره مفضوحا ومكشوفا إذ ليس في الإسلام جهة أو سلطة كهنوتية تحتكر تفسير النص أو اعتماد تفسير له غير ما استقرت عليه الأمة في قرونها السابقة، وهي التفاسير التي لم تتدخل السلطة في صياغتها أصلا. كذلك فإن النص المعصوم هو الحاكم المهيمن على النموذج الإسلامي والذي يرتبط بحياة المسلمين في أدق شؤونهم كالصلاة ويحفظه حتى الصغار في الكتاتيب.
وهذا بخلاف النموذج العلماني الذي تملك فيه السلطة الجديدة إلغاء القديم وحذفه وإسقاطه، ووضع دستور جديد يمنحها الشرعية كما يمنحها المبرر لمحاكمة وإدانة خصومها.
الثاني: وجود تجربة عملية واقعية استمرت لمدة ثلاثين سنة، هي عصر الخلافة الراشدة، التي تمثل التطبيق والنموذج السياسي الملهم، ففي حين تحاول كل الفلسفات الوصول إلى نموذج لم يوجد بعد تحل فيه سعادة الإنسان، يحاول المسلمون الاقتراب من نموذج الخلافة الراشدة الذي تحقق فعلا، والذي شهد كافة مراحل تقلب الدولة: التأسيس والنضوج والرفاهية والفتن الداخلية.
بهذين الأمرين، النص المعصوم والتجربة التاريخية، تميزت التجربة الإسلامية عن سائر التجارب السياسية الأخرى.
ونحن إذا فقدنا النص المعصوم لوجدنا أنفسنا نقرأ تاريخا آخر ونستنتج منه أحكاما أخرى، ولنضرب على هذا بعض الأمثلة:
1. إن أي تقييم مادي لعصر الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه سيكون في صف معاوية لا في صف عليٍّ، فعلي لم يستطع إقرار الأمن طوال فترة خلافته التي استمرت لأربع سنوات، ولم يمثل قيادة زعامية لأنصاره كتلك التي مثلها معاوية، ففي حين تكتل أهل الشام خلف معاوية تفرق أهل الأمصار عن علي، ثم افترق معسكر أنصاره فخرج منه الشيعة والخوارج، ثم اغتيل على يد الخوارج. في المقابل: استمر معاوية زعيما محبوبا على أهل الشام، ثم حكم بعد علي لمدة عشرين سنة استطاع فيها توحيد الأمة وإعادة عصر السيادة واستئناف الفتوح الإسلامية وتوسع الدولة.
هذا الذي تسوق إليه القراءة المادية (العلمانية) لم يعتنقه أحد في أجيال المسلمين، بل ظل علي رضي الله عنه أجل وأعلى عند المسلمين من معاوية، بل تجتمع الأمة على أن معاوية وأنصاره هم الفئة الباغية بنص معصوم من السنة كشف عن هذه الحقيقة "ويح عمار تقتله الفئة الباغية"، وعلي هو خليفة المسلمين الراشد في حين أن معاوية هو أول ملوك الإسلام غير المحسوب على الفترة الراشدة، وهي الفترة التي بدأ فيها انحلال عرى الإسلام بعروة الحكم.
وهكذا كان للنص المعصوم أثره الواضح في الانحياز الفكري والشعوري واختيار الموقف الأخلاقي للأمة كلها.
2. نفس الكلام يُقال عن عبد الملك بن مروان –وقائد جيشه الحجاج بن يوسف الثقفي- في مقابل عبد الله بن الزبير، فقد استطاع عبد الملك بن مروان في ظروف سياسية أقرب إلى المستحيل وانطلاقا من انقسام في الشام أن يستعيد السيطرة على كل الأمة وأن يعيد توحيدها وأن يستأنف من جديد عصر الفتوحات بعد توقفه الثاني وأن يبدأ موجة إعمارية واسعة وأن يضع أساس تعريب الدواوين وتعريب العملة وغير ذلك. بينما كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قد جاءته الخلافة تسعى وظل خليفة تسعة أعوام لا ينازعه إلا هذه القطعة في الشام، إلا أنه لم يستطع الحفاظ على هذا الملك الواسع وظل يتناقص ويؤخذ من بين يديه حتى تفرق عنه بعض أهله وقُتِل في النهاية.
إن القراءة المادية للتاريخ تنحاز مباشرة إلى عبد الملك بن مروان، وتنحاز أيضا إلى قائد جيشه الحجاج بن يوسف الثقفيما كان ذلك كله ليكون لولا أن النص المعصوم والتجربة التاريخية الراشدة رسخت صورة للحق وجعلته فوق القوة، بينما انعدام هذا يؤول عمليا إلى أن الحق هو ما تقرره القوة وتسبغ عليه الشرعية.
وقد بلغت هذه الحساسية الأخلاقية مبلغا عظيما، إلى حد أن بعض المسلمين بل وبعض علمائهم يحتدون في وصف التاريخ الإسلامي والحكم عليه وتقييمه، ويبالغون في ذلك مبالغة شديدة تصل إلى أن يتخذها بعض العلمانيين مدخلا للطعن في التاريخ الإسلامي كله بل وفي صلاحية الإسلام ليكون حلا وليصنع نموذجا يمكن تطبيقه في واقع البشر.
لكن هنا تولد إشكالية أخرى، وهي بالأحرى موجودة بكثافة عند العلمانيين العرب، ولم أرها بذات القدر عند المستشرقين، تلك هي أن نصف قراءتهم للتاريخ علمانية مادية ونصفها الآخر أخلاقية مثالية، فهو في قراءته المادية يرى أن ثلاثة من الخلفاء الراشدين قُتِلوا ويعتبر هذا نموذج فشل في حفظ الدولة لكنه لو ارتدى النظارة الأخلاقية لرأى فيها اقترابا من الناس إلى الحد الذي يستطيع الغريب الأجنبي الصلاة في الصف الأول وليس بينه وبين عمر (حاكم نصف العالم المعروف وقتها) حجاب، أو أن يأتي قوم من مصر والعراق يريدون خلع أمير المؤمنين فلا يتعرض لهم أحد حتى يناقشهم ويجادلهم ويمنع الناس عن التعرض لهم وهم يمثلون تهديدا عليه. ثم هو إذا قرأ تاريخ يزيد أو الحجاج أو بعض فصول التاريخ العباسي أو المملوكي ارتدى النظارة الأخلاقية المثالية فنسي ما لهؤلاء من أثر في تمكين الدولة وتوسيعها وإنهاضها ولم يثر إعجابة أن هؤلاء جميعا مات على فراشه!!
نحن أيضا كنا سنقع في هذا الاضطراب لولا وجود النص المعصوم الذي يمثل حاكما على قراءة التاريخ، ومن ثَمَّ يمثل حاكما ومحددا للنموذج السياسي المنشود، وهكذا يحملنا هذا النص المعصوم على النظر بعمق وفهم للتاريخ، تاريخ الخلافة الراشدة خصوصا، ذلك أننا لا يمكن أن نحكم على سيدنا أبي بكر بالانفراد بالرأي ولا سيدنا عمر بالقسوة ولا سيدنا عثمان بالضعف، ولا على سيدنا علي بالفشل، ولا على الصحابة فيما وقع بينهم بخبث النفس أو سوء النية والقصد، حاشاهم جميعا.
لا يمنعنا من كل هذا إلا النص المعصوم الذي أثنى عليهم وأمرنا بتقديرهم وتوقيرهم، فكشف لنا من أمر نفوسهم الغيب الخفي الذي يخفى على جميع المؤرخين إذ يقرأون ويحكمون على شخصيات التاريخ، وهكذا يحقق لنا النص المعصوم عمقا في قراءة التاريخ، وفهم الشخصية وتفسير الأحداث، فوق ما يعطينا من ترسيخ للحق ومن انحياز حضاري يهدينا تجاه قضايا رئيسية فارقة في مسيرة الأمة كلها.
إنه بقدر ما عَصَمَنا النص المعصوم من قراءة مادية وحكم مادي على شخصيات وأحداث التاريخ، بقدر ما عصمنا كذلك من قراءة أخلاقية مثالية غير واقعية.. إلا أن الانحياز النهائي للحضارة الإسلامية هو انحياز أخلاقي وليس ماديا (كما قدمنا في مثال علي ومعاوية رضي الله عنهما ومكانتهما لدى الأمة الإسلامية).. ولهذا فنحن نواجه داخل الفكر الإسلامي نظرة أخلاقية مثالية للتاريخ وللنموذج السياسي بأكثر مما نواجه نظرة مادية علمانية، نواجه من يزعم أن الإسلام لم يقدم نموذجا سياسيا مثاليا تمسكا بنظرته الأخلاقية المثالية وإن جرَّه ذلك للإسارة لبعض الصحابة، أكثر مما نواجه من يزعم أن الإسلام لم يحقق نجاحا ماديا وحضارة زاهرة.
تلك هي "المشكلة الأخلاقية المثالية" التي نواجهها لدى تقييم الحضارة الإسلامية.
نشر في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية
ولذلك ليس عجيبا أن تجد كاتبا علمانيا يؤلف كتابا عن الحجاج المفترى عليه، إذ قراؤته الخالية من الانحياز الإسلامي تدفع لذلك.
الأول: وجود النص المعصوم من القرآن والسنة والذي لا يستطيع حاكم إلغاءه أو تغييره أو إسقاطه، حتى إن حاول تأويله أو حمله على وجه باطل كان أمره مفضوحا ومكشوفا إذ ليس في الإسلام جهة أو سلطة كهنوتية تحتكر تفسير النص أو اعتماد تفسير له غير ما استقرت عليه الأمة في قرونها السابقة، وهي التفاسير التي لم تتدخل السلطة في صياغتها أصلا. كذلك فإن النص المعصوم هو الحاكم المهيمن على النموذج الإسلامي والذي يرتبط بحياة المسلمين في أدق شؤونهم كالصلاة ويحفظه حتى الصغار في الكتاتيب.
وهذا بخلاف النموذج العلماني الذي تملك فيه السلطة الجديدة إلغاء القديم وحذفه وإسقاطه، ووضع دستور جديد يمنحها الشرعية كما يمنحها المبرر لمحاكمة وإدانة خصومها.
الثاني: وجود تجربة عملية واقعية استمرت لمدة ثلاثين سنة، هي عصر الخلافة الراشدة، التي تمثل التطبيق والنموذج السياسي الملهم، ففي حين تحاول كل الفلسفات الوصول إلى نموذج لم يوجد بعد تحل فيه سعادة الإنسان، يحاول المسلمون الاقتراب من نموذج الخلافة الراشدة الذي تحقق فعلا، والذي شهد كافة مراحل تقلب الدولة: التأسيس والنضوج والرفاهية والفتن الداخلية.
بهذين الأمرين، النص المعصوم والتجربة التاريخية، تميزت التجربة الإسلامية عن سائر التجارب السياسية الأخرى.
ونحن إذا فقدنا النص المعصوم لوجدنا أنفسنا نقرأ تاريخا آخر ونستنتج منه أحكاما أخرى، ولنضرب على هذا بعض الأمثلة:
1. إن أي تقييم مادي لعصر الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه سيكون في صف معاوية لا في صف عليٍّ، فعلي لم يستطع إقرار الأمن طوال فترة خلافته التي استمرت لأربع سنوات، ولم يمثل قيادة زعامية لأنصاره كتلك التي مثلها معاوية، ففي حين تكتل أهل الشام خلف معاوية تفرق أهل الأمصار عن علي، ثم افترق معسكر أنصاره فخرج منه الشيعة والخوارج، ثم اغتيل على يد الخوارج. في المقابل: استمر معاوية زعيما محبوبا على أهل الشام، ثم حكم بعد علي لمدة عشرين سنة استطاع فيها توحيد الأمة وإعادة عصر السيادة واستئناف الفتوح الإسلامية وتوسع الدولة.
هذا الذي تسوق إليه القراءة المادية (العلمانية) لم يعتنقه أحد في أجيال المسلمين، بل ظل علي رضي الله عنه أجل وأعلى عند المسلمين من معاوية، بل تجتمع الأمة على أن معاوية وأنصاره هم الفئة الباغية بنص معصوم من السنة كشف عن هذه الحقيقة "ويح عمار تقتله الفئة الباغية"، وعلي هو خليفة المسلمين الراشد في حين أن معاوية هو أول ملوك الإسلام غير المحسوب على الفترة الراشدة، وهي الفترة التي بدأ فيها انحلال عرى الإسلام بعروة الحكم.
وهكذا كان للنص المعصوم أثره الواضح في الانحياز الفكري والشعوري واختيار الموقف الأخلاقي للأمة كلها.
2. نفس الكلام يُقال عن عبد الملك بن مروان –وقائد جيشه الحجاج بن يوسف الثقفي- في مقابل عبد الله بن الزبير، فقد استطاع عبد الملك بن مروان في ظروف سياسية أقرب إلى المستحيل وانطلاقا من انقسام في الشام أن يستعيد السيطرة على كل الأمة وأن يعيد توحيدها وأن يستأنف من جديد عصر الفتوحات بعد توقفه الثاني وأن يبدأ موجة إعمارية واسعة وأن يضع أساس تعريب الدواوين وتعريب العملة وغير ذلك. بينما كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قد جاءته الخلافة تسعى وظل خليفة تسعة أعوام لا ينازعه إلا هذه القطعة في الشام، إلا أنه لم يستطع الحفاظ على هذا الملك الواسع وظل يتناقص ويؤخذ من بين يديه حتى تفرق عنه بعض أهله وقُتِل في النهاية.
إن القراءة المادية للتاريخ تنحاز مباشرة إلى عبد الملك بن مروان، وتنحاز أيضا إلى قائد جيشه الحجاج بن يوسف الثقفيما كان ذلك كله ليكون لولا أن النص المعصوم والتجربة التاريخية الراشدة رسخت صورة للحق وجعلته فوق القوة، بينما انعدام هذا يؤول عمليا إلى أن الحق هو ما تقرره القوة وتسبغ عليه الشرعية.
وقد بلغت هذه الحساسية الأخلاقية مبلغا عظيما، إلى حد أن بعض المسلمين بل وبعض علمائهم يحتدون في وصف التاريخ الإسلامي والحكم عليه وتقييمه، ويبالغون في ذلك مبالغة شديدة تصل إلى أن يتخذها بعض العلمانيين مدخلا للطعن في التاريخ الإسلامي كله بل وفي صلاحية الإسلام ليكون حلا وليصنع نموذجا يمكن تطبيقه في واقع البشر.
لكن هنا تولد إشكالية أخرى، وهي بالأحرى موجودة بكثافة عند العلمانيين العرب، ولم أرها بذات القدر عند المستشرقين، تلك هي أن نصف قراءتهم للتاريخ علمانية مادية ونصفها الآخر أخلاقية مثالية، فهو في قراءته المادية يرى أن ثلاثة من الخلفاء الراشدين قُتِلوا ويعتبر هذا نموذج فشل في حفظ الدولة لكنه لو ارتدى النظارة الأخلاقية لرأى فيها اقترابا من الناس إلى الحد الذي يستطيع الغريب الأجنبي الصلاة في الصف الأول وليس بينه وبين عمر (حاكم نصف العالم المعروف وقتها) حجاب، أو أن يأتي قوم من مصر والعراق يريدون خلع أمير المؤمنين فلا يتعرض لهم أحد حتى يناقشهم ويجادلهم ويمنع الناس عن التعرض لهم وهم يمثلون تهديدا عليه. ثم هو إذا قرأ تاريخ يزيد أو الحجاج أو بعض فصول التاريخ العباسي أو المملوكي ارتدى النظارة الأخلاقية المثالية فنسي ما لهؤلاء من أثر في تمكين الدولة وتوسيعها وإنهاضها ولم يثر إعجابة أن هؤلاء جميعا مات على فراشه!!
نحن أيضا كنا سنقع في هذا الاضطراب لولا وجود النص المعصوم الذي يمثل حاكما على قراءة التاريخ، ومن ثَمَّ يمثل حاكما ومحددا للنموذج السياسي المنشود، وهكذا يحملنا هذا النص المعصوم على النظر بعمق وفهم للتاريخ، تاريخ الخلافة الراشدة خصوصا، ذلك أننا لا يمكن أن نحكم على سيدنا أبي بكر بالانفراد بالرأي ولا سيدنا عمر بالقسوة ولا سيدنا عثمان بالضعف، ولا على سيدنا علي بالفشل، ولا على الصحابة فيما وقع بينهم بخبث النفس أو سوء النية والقصد، حاشاهم جميعا.
لا يمنعنا من كل هذا إلا النص المعصوم الذي أثنى عليهم وأمرنا بتقديرهم وتوقيرهم، فكشف لنا من أمر نفوسهم الغيب الخفي الذي يخفى على جميع المؤرخين إذ يقرأون ويحكمون على شخصيات التاريخ، وهكذا يحقق لنا النص المعصوم عمقا في قراءة التاريخ، وفهم الشخصية وتفسير الأحداث، فوق ما يعطينا من ترسيخ للحق ومن انحياز حضاري يهدينا تجاه قضايا رئيسية فارقة في مسيرة الأمة كلها.
إنه بقدر ما عَصَمَنا النص المعصوم من قراءة مادية وحكم مادي على شخصيات وأحداث التاريخ، بقدر ما عصمنا كذلك من قراءة أخلاقية مثالية غير واقعية.. إلا أن الانحياز النهائي للحضارة الإسلامية هو انحياز أخلاقي وليس ماديا (كما قدمنا في مثال علي ومعاوية رضي الله عنهما ومكانتهما لدى الأمة الإسلامية).. ولهذا فنحن نواجه داخل الفكر الإسلامي نظرة أخلاقية مثالية للتاريخ وللنموذج السياسي بأكثر مما نواجه نظرة مادية علمانية، نواجه من يزعم أن الإسلام لم يقدم نموذجا سياسيا مثاليا تمسكا بنظرته الأخلاقية المثالية وإن جرَّه ذلك للإسارة لبعض الصحابة، أكثر مما نواجه من يزعم أن الإسلام لم يحقق نجاحا ماديا وحضارة زاهرة.
تلك هي "المشكلة الأخلاقية المثالية" التي نواجهها لدى تقييم الحضارة الإسلامية.
نشر في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية
ولذلك ليس عجيبا أن تجد كاتبا علمانيا يؤلف كتابا عن الحجاج المفترى عليه، إذ قراؤته الخالية من الانحياز الإسلامي تدفع لذلك.
Published on April 09, 2016 05:42
April 8, 2016
تبسيط تاريخ مصر الحديث (1)
شارك في كتابته: د. عمرو عادل
شهد المجتمع المصري تطورا فارقا في القرنين الأخيرين بداية منذ الحملة الفرنسية على مصر وحتى اللحظة الحاضرة. ويمكن تقسيم هذه الحقبة إلى ثماني فترات، هي:
1. قبل الحملة الفرنسية2. الحملة الفرنسية3. عصر محمد علي 4. عصر الأسرة العلوية5. الاحتلال الإنجليزي6. ثورة 1919 ونتائجها7. حقبة العسكر8. ثورة يناير
بلغت صفحات هذه الدراسة نحو ثلاثمائة صفحة، ويتوقع أن تصدر قريبا إن شاء الله، ثم آثرنا تقديم خلاصتها في مقالات منشورة، فهذه المقالات هي بمثابة تهذيب التهذيب أو خلاصة الخلاصة، لتعميم الفائدة.
تركز الدراسة على المقارنة بين "قوة الدولة" و"قوة المجتمع" في هذه العهود المختلفة، وقد خلصت إلى نتائج من أهمها أن لحظات التقدم هي لحظات التوازن بين هاتين القوتين، بينما لحظات الضعف والهزيمة هي اللحظات التي زاد فيها تغول وتوحش الدولة على حساب إضعاف وكسر المجتمع، وأن تمكين المجتمع هو المشروع الذي حملته الثورات وحركات النهضة والإحياء بينما كان تقوية الدولة هو المشروع الذي حمله الاحتلال وعملاء الاحتلال.
وحددت الدراسة عوامل القوة في أربعة عناصر:
(1) السلاح: الذي يمثل قوة الردع أو قوة الإجبار والتنفيذ.(2) الوعي: الذي يمثل المفاهيم والمبادئ والقيم الحاكمة.(3) إدارة الثروة (المؤسسات): وهي المؤسسات التي تدير ثروات ومقدرات البلد.(4) التشريع والقانون: وهي التي تعبر عن القيم والإجراءات الحاكمة ونظام إنفاذها.
وسَعَتْ الدراسة للنظر في كل عنصر من هذه العناصر لرصد توزعه بين الدولة والمجتمع، وخرجت بتقريبات رقمية لهذه النسبة، وضعتها في رسوم بيانية لشرح مسار تطور المجتمع المصري بشكل أفضل بصريا.
وقد اعتبرت الدراسة أن القوة متوزعة بالتساوي بين هذه العناصر الأربعة، وذلك لطول الأمد (أكثر من قرنين من الزمان) مع الاعتراف بأن "السلاح" هو الأعلى والأهم في المراحل الفاصلة، يليه بقدر ما "الوعي"، ولكن مراحل السلم والاستقرار يكون العنصر الأهم هو "المؤسسات والثروة" و"التشريع والقانون" ويليهما الوعي والسلاح.
وحيث اعتمدت الدراسة أسلوب التبسيط ورسم المسارات العامة، فقد جعلنا نسبة القوة متوزعة بالتساوي بين هذه العناصر الأربعة، باعتبار أن الفترة المدروسة تنوعت بين سلم وحرب، وبين اضطراب واستقرار مما يحذف أثر القوة النسبية لعنصر من العناصر في لحظة من اللحظات.
واعتمدت الدراسة منهجا لتحليل كل عنصر من عناصر القوة على هذا النحو الآتي:
أولا: السلاح
السلطة المجتمع 100 نقطة امتلاك السلاح
20 نقطة الفارق في قوة السلاح
20 نقطة قرار استخدام السلاح
20 نقطة نسبة المرتزقة إلى المجتمع في القوات النظامية
20 نقطة نسبة المشاركة في مقاومة العدوان الخارجي
20 نقطة
ثانيا: الوعي
السلطة المجتمع 100 نقطة التحكم في إدارة المؤسسات التعليمية
20 نقطة التحكم في تمويل المؤسسات التعليمية
20 نقطة التحكم في المعلمين
20 نقطة التحكم في المؤسسات الدعوية
20 نقطة التحكم في المطبوعات ومصادر المعلومات
20 نقطة
ثالثا: المؤسسات والثروة
السلطة المجتمع 100 نقطة نسب توزع الثروة
50 نقطة نسب التحكم في الثروة
50 نقطة
رابعا: التشريع والقانون
السلطة المجتمع 100 نقطة امتلاك مؤسسات التشريع "إصدار القوانين"
25 نقطة امتلاك مؤسسات "القضاء"
25 نقطة السيطرة على المصادر المالية لمؤسسات التشريع والقضاء
25 نقطة الإمداد بالكوادر البشرية للمؤسستين
25 نقطة
وقد اعتمدنا التساوي في النقاط بين أدوات القياس لكل عنصر لضرورة التبسيط، لأن الدراسة تهدف إلى رسم ملامح الصورة العامة، ويحتاج التوزيع الدقيق للنسب إلى عمل أكثر عمقا وتعقيدا. كذلك اعتمدنا رفع النقاط إلى (100) لمزيد من الوضوح في التحليل، والذي سيظهر أوضح ما يكون عند رسم الشكل البياني.
في هذه الخلاصة لن نعرض إلا الرسوم البيانية الأخيرة التي تقارن بين قوة السلطة وقوة المجتمع.
(1)ما قبل الحملة الفرنسية
كان التوازن قائما في توزيع القوى بين الدولة وبين المجتمع:
1. فقد تفوقت الدولة على المجتمع في قوة السلاح وكثرته وامتلاكها قرار استخدامه، وبهذا كانت متكفلة بصد العدو الغازي، إلا أنها لم تكن تحتكره بل كان المجتمع يمتلك قدرا وافرا منه، خصوصا في الصعيد الذي كان يتمتع بنوع من الاستقلال الذاتي.
2. بينما تفوق المجتمع على الدولة في صناعة الوعي، ذلك أنه لم يكن بيد السلطة وسيلة مركزية لنشر الأفكار والمعلومات وصناعة وعي موحد للجماهير، كما أن السلطة لم تكن متدخلة في أمور التعليم الذي كان يديره المجتمع بشكل شبه كامل، فكانت المدارس والمساجد ينفق عليها من الأوقاف، ويديرها العلماء وطلبة العلم في ظل غيبة شبه كاملة من السلطة عن التمويل والإدارة لهذه المؤسسات. فحتى الأغنياء وأصحاب رأس المال يتوقف تحكمهم عند التبرع وإنشاء المدارس ولا يصنعون مناهجها ولا يتحكمون في توجيهها.
3. وتحقق نوع من التوازن، مع تفوق للدولة في مسألة المؤسسات وإدارة الثروة، فقد اقتصرت وظيفة السلطة على إدارة ملفات الأمن والدفاع، بينما ظلت باقي المؤسسات تحت إدارة المجتمع، مثل نظام الحرف والمهن الذي كان يمثل بيئة تكافلية ورابطة اجتماعية، ولم تكن الدولة تتحكم فيه ولا تديره.
4. كما تحقق نوع من التوازن، مع تفوق للمجتمع في مسألة التشريع والقانون، إذ لا تتدخل السلطة في التشريع، بل ظلت الشريعة الإسلامية مهيمنة على مجال التشريع والتقنين، وهي وظيفة يمارسها العلماء والقضاة بشكل أساسي، ويقتصر دور السلطة على تقنينات تفصيلية وإجرائية. كذلك فقد كانت مؤسسة القضاء مستقلة ماليا إذ تعتمد على الأوقاف، ولم تكن السلطة العثمانية تعين سوى 5 من بين 36 منصبا قضائيا. وكانت للقوى الاجتماعية (العلماء، القضاة، الزعماء) أدوار فاعلة في الاعتراض على السلطة وتمثيل المجتمع أمامها، فكانوا كالطبقة بين الحكام والعامة.
الخلاصة:
تفوقت الدولة على المجتمع في مجال السلاح بفارق كبير، مما أدى لسرعة انهيارها أمام الغزو الفرنسي، إلا أن وجود قوى اجتماعية فاعلة وامتلاكها لعوامل قوة مؤثرة في المجتمع مكنها من سرعة أن تحل بديلا عن الدولة وأن تبدأ مقاومتها ضد الغزو الفرنسي.
وبحساب مجموع القوى بين الدولة والمجتمع نرصد أن المجتمع امتلك حوالي (47.7%) من ميزان القوة، بينما امتلكت السلطة (52.3%) منها.
ويتضح شكل توزع القوى بين الدولة والمجتمع من خلال هذا الرسم البياني:
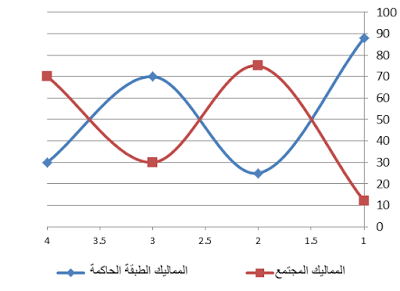 1 القوة المسلحة 2 صناعة الوعي 3 المؤسسات التنفيذية والثروة 4 التشريع والقانون (2)الحملة الفرنسية
1 القوة المسلحة 2 صناعة الوعي 3 المؤسسات التنفيذية والثروة 4 التشريع والقانون (2)الحملة الفرنسية
ما إن انهارت السلطة المملوكية بهزيمة جيش إبراهيم ومراد بك أمام الجيش الفرنسي حتى ظهرت القوة الشعبية لتجاهد المحتل، وقد فاضت الكتب التي أرخت لذلك الوقت بالمقاومة الباسلة المستمرة من المصريين للغزاة الفرنسيين، وبرغم الفارق الهائل في القوة فقد سارت المعارك بحيث تبدو وكأنها بين جيشين متكافئين، وقد حقق المصريون انتصارات غالية مع فارق هائل في أعداد الشهداء منهم مقابل أعداد القتلى من الفرنسيين. وقُدِّر عدد الشهداء بمئات الآلاف في وقت كان تعداد المصريين فيه مليونين فقط.
ومثلما انهار ملف "الدفاع" الذي كان بيد السلطة، انهار ملف "الأمن" أيضا بزوال هذه السلطة، وسارت حالة من الهجرة الجماعية لمن استطاع من مصر، وصحب ذلك عمليات نهب وسلب وإغارات واسعة، كل ذلك في أول فترة العدوان الفرنسي.
وصار الحال على هذا النحو في ميزان استعمال القوة حسب العناصر الأربعة:
1. كثر السلاح بأيدي المجتمع بما فقدته السلطة المملوكية من أسلحة، وبما استعملوه في معاركهم مع الفرنسيين، وبما غنموه منهم، وبما أعادوا تصنيعه في حمأة المقاومة، مع بقاء الفارق الهائل بين الطرفين في قوة السلاح، ولكن تساوى الطرفان في القدرة على استعمال السلاح وفي قرار استعماله. مما أحدث نوعا من التوازن في معركة "القوة المسلحة" بين الطرفين.
2. وفشل الفرنسيون تماما في "معركة الوعي" رغم محاولاتهم المضنية، وظلت القيادة الفكرية للمجتمع قائمة في شيوخ الأزهر ومشايخ الطرق الصوفية وزعماء القبائل ونقباء الحرف والمهن، فظل هؤلاء على موقعهم القديم من تمثيل المجتمع وقيادته، فكان المجتمع أقوى من السلطة الفرنسية في تكوين وعي الجماهير.
3. بينما تفوق الفرنسيون –من موقعهم كسلطة احتلال- في التحكم في الثروة، فقد ضاعفوا من الضرائب على المصريين، وحاولوا السيطرة على الأوقاف من خلال أن عهدوا بإدارتها للنصارى من القبط والشوام، فاتخذها أولئك كالمغنم وتعطلت رواتب كثير من العلماء والمؤذنين والفقهاء والعميان والمرضى وغيرهم. وأسسوا كذلك لجمعية تمثيلية تكون كالمحلل للمحتل من خلال التمثيل السياسي للمجتمع، إلا أن عدم الثقة فيهم جعلت الفرنسيين لا يعطونهم صلاحيات حقيقية.
4. فيما بقيت مؤسسات التشريع والقانون على حالها تقريبا، ذلك أن قصر الفترة التي قضاها الفرنسيون في مصر، وامتلائها بالمقاومة والاضطرابات، وحاجتهم إلى مهادنة فئات من الشعب المصري خصوصا في هذه المسائل الحساسة، كل ذلك حال دون إجراء كثير تغيير في هذه المؤسسات، فبقي المجتمع محتفظا بتفوقه فيها.
الخلاصة:
عمل الاحتلال الفرنسي على تقوية سلطة الدولة وكسر المجتمع، وكانت أول محاولة لكسر وتغيير أنظمة المجتمع من خلال تحطيم أبواب الحارات ومحاولة التحكم في الأوقاف وصناعة تمثيل سياسي، إلا أنه لم ينجح في ذلك، ولما لم تطل فترة بقائه في مصر فإنه عجز عن تفكيك القوى الاجتماعية التي قادت المقاومة، ومثلت بديلا حقيقيا عن سلطة المماليك بعد انهيارها.
وبحساب مجموع القوى بين الدولة والمجتمع نرصد أن المجتمع امتلك حوالي (61%) من ميزان القوة، بينما امتلكت السلطة (39%) منها، وأبلغ دليل على قوة المجتمع هو قدرتهم على فرض محمد علي واليا عليهم رغما عن السلطان العثماني.
ويتضح شكل توزع القوى بين الدولة والمجتمع من خلال هذا الرسم البياني:

1 القوة المسلحة 2 صناعة الوعي 3 المؤسسات التنفيذية والثروة 4 التشريع والقانون
(3)عصر محمد علي
وهو العصر الذي أعيد فيه تشكيل المجتمع المصري، إذ غُرِس نظام الدولة الحديثة بديلا عن النظام الإسلامي، وتغيرت وجوه العلاقات بين المجتمع والسلطة، وتأسس وضع جديد تماما، بالقهر وبالسيف، حتى كانت مصر بعد محمد علي شيئا مختلفا عنها من قبله.
ومن خلال عناصر القوة الأربعة التي نتناولها بالبحث سنرى كيف حطم محمد علي النظام القائم، واستبدل به نظام "الدولة الحديثة" التي تتغول فتشمل كل شيء وتتحكم في كل شيء.
1. ففي جانب السلاح قرر محمد علي تجريد الشعب من السلاح وجعله محتكرا بيد الدولة وحدها، ولم يعطله عن هذا أن المجتمع المسلح استطاع صد الاحتلال الإنجليزي (حملة فريزر 1807) بل أصر أكثر على ألا يبقى "السلاح في يد الفلاحين". وأسس جيشا على النظام الحديث وبإشراف من خبير فرنسي، سلك فيه ذات المسلك الأوروبي في الاستعباد ومعاملة الجنود كأنهم عبيد، ونزعهم من كل قيمة إنسانية أو أخلاقية وزرع تقديس الأوامر العسكرية.. فظهر بهذا أول جيش ليس له مرجعية إسلامية عليا. وهذا بخلاف الإجراءات التي استعملت في التجنيد وفي الحد من التهرب وفي التدريب، وهي إجراءات غربية بحتة خالية من كل قيمة أو ضوابط إسلامية. بل يمكن القول بأن "البناء الإحصائي والبيروقراطي" للدولة المصرية إنما كان لأجل الجيش بالأصل. وذات الكلام يُقال في الشأن الأمني، فقد كان من بدايات الإجراءات التي اتخذها محمد علي اختراع مناصب أمنية، ووصل في التحكم إلى حد منع التنقل بين القرى إلا بتصريح مرور.
2. وفي جانب الوعي والقيادة الفكرية شن محمد علي حملة عنيفة لكسر جميع القيادات الفكرية والزعامات الاجتماعية، وشمل بالإقصاء –قتلا ونفيا وتحجيما ومطارة- كافة القيادات: العلماء، ومشايخ الطرق الصوفية، زعماء القبائل ورؤوس العائلات الكبيرة، نقباء المهن والحرف، حتى قال الشيخ محمد عبده "لم يترك في بر مصر رأسا يقول: أنا". وأنشأ المدارس على النظام الأوروبي الحديث فدخل بذلك نظام للتعليم يخالف ويزاحم النظام الأزهري، وأنشأ المطابع التي كانت مملوكة للدولة ومن هنا بدأت تعلو يد الدولة وقدرتها على صناعة وعي موحد. إلا أن التعليم الأزهري بقي ولم يختفِ وظلت للمشايخ قدرة نسبية على توجيه الوعي وصناعته وإن كانت أضعف بكثير من ذي قبل.
3. واستطاعت دولة محمد علي أن تنشئ مؤسسات قاهرة تتحكم في الإدارة والسلطة، فقد كان نظامه المركزي القائم على إعادة التحكم في الزراعة والري والصناعة قد أنهى بشكل عملي نظام نقابات المهن والحرف والوظائف، وأنهى الوضع التكافي الاجتماعي القديم لحساب اتخاذ كل هذه الأنشطة كأدوات وعناصر تخدم في جهاز الدولة وضمن خطتها العامة (والوحيدة بالطبع). ثم كانت ضربته الهائلة الكبرى والتي لم يستطعها أحد من قبله باستيلاء الدولة على الأوقاف ومنح السلطة لنفسها الحق في الإشراف على إدارة الأوقاف وأخذ ريعها وإعادة إنفاقها في مصارفها.
4. وبدأت في عهد محمد علي بذرة تدخل الدولة في مؤسسات التشريع والقضاء، فظهرت مؤسسات تزاحم القضاء الشرعي، مثل "المجالس القضائية" التي صارت إليها مهمة التشريع ووضع القوانين، لكن ظلت الهيمنة العامة للقضاء الشرعي، مما يجعل هذه النقطة نقطة توازن وحيدة بين السلطة والمجتمع في عصر محمد علي.
الخلاصة:
تغولت الدولة على حساب المجتمع في كل عناصر القوة باستثناء الرابع "التشريع والقانون"، وعاش الشعب المصري واحدة من أقسى لحظات تاريخه في استبداد السلطة.
وبحساب مجموع القوى بين الدولة والمجتمع نرصد أن المجتمع امتلك حوالي (24%) من ميزان القوة، بينما امتلكت السلطة (76%) منها.
ويتضح شكل توزع القوى بين الدولة والمجتمع من خلال هذا الرسم البياني:

1 القوة المسلحة 2 صناعة الوعي 3 المؤسسات التنفيذية والثروة 4 التشريع والقانون
(4)عصر الأسرة العلوية
يعد عصر الأسرة العلوية (منذ نهاية حكم محمد علي وحتى الاحتلال الإنجليزي) امتدادا للنظام الذي أسسه محمد علي، وقد ظلت عوامل القوة كما هي في عصر محمد علي:
1. فقد استمر السلاح محتكرا بيد الدولة، وليس للمجتمع حق فيه.
2. واستمرت القيادة الفكرية والتوجيهية حصريا للدولة التي امتلكت المطبعة والصحف كوسائل صناعة وعي مركزية.
3. بينما قلت نسبة إدارة السلطة للثروة بقدر بسيط، وزادت نسبة مشاركة المجتمع، وذلك بعد قرارات الخديو سعيد بتخفيض الضرائب على الفلاحين وإعطائهم الحق في تملك الأراضي من بعد ما كانت احتكارا حصريا للباشا والأسرة الحاكمة، كذلك فقد سمح الخديو سعيد للمصريين بالترقي إلى المراتب العليا في الجيش، وكان هذا إصلاحا سيكون له أثر بعيد في حدوث الثورة العرابية.
4. لكن الأزمة الكبرى كان في جانب مؤسسات التشريع والقانون، إذ زاد الجور على حق الشريعة والمحاكم الشرعية لحساب القوانين الوضعية، إذ شهدت هذه الفترة استيراد قوانين فرنسية، وإنشاء المحاكم القنصلية الأجنبية، ثم المحاكم المختلطة، وقد كان هذان النوعان من المحاكم تحت السيطرة الكاملة للأجانب الذين تدفقوا على مصر في عصر محمد علي وأبنائه، وفقدت مصر استقلالها التشريعي (ولم تستعده جزئيا ونظريا إلا في معاهدة 1936 وعمليا في 1949، أي مدة قرن من الزمان).
ولهذا، ففي الوزن الأخير لعوامل القوة، نجد أن النسبة لم تتغير كثيرا، فقد امتلك المجتمع (23%) من عوامل القوة، بينما امتلكت السلطة (77%).
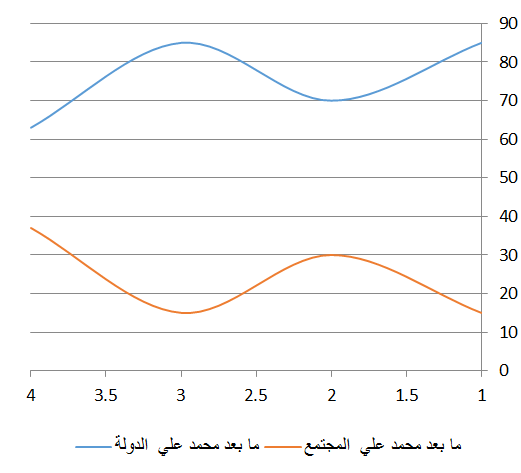
1 القوة المسلحة 2 صناعة الوعي 3 المؤسسات التنفيذية والثروة 4 التشريع والقانون
في أواخر عصر الأسرة العلوية (ما قبل الاحتلال الإنجليزي) طرأت عدة تغيرات على واقع المجتمع المصري، فتغيرت معها أوزان القوة النسبية بين المجتمع والسلطة على هذا النحو:
1. ففي مجال القوة المسلحة، أتاح زيادة عدد المصريين في الرتب العليا للجيش من نزوع هذا الجيش نحو أن يكون تعبيرا عن المجتمع لا عن السلطة كما هو الحال في ظل سيطرة العناصر الأجنبية (والتي هي في حكم المرتزقة لانفصالها عن المجتمع طبقيا وعرقيا ولغويا وثقافيا). وكان هذا الانقسام المصري الأجنبي في صفوف الجيش يُحسم في كثير من الأحيان لصالح المصريين.
2. وظهرت في المجتمع المصري قيادات فكرية جديدة بروح جديدة، أبرزها: جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده، وعبد الله النديم وغيرهم، وقد أثار هؤلاء روحا جديدة بين الشيوخ والعامة تحرضهم على الثورة ضد الاستبداد. وكان لهم أثر فكري وعملي بعيد. ولا ريب أن انتشار التعليم وما انتشر من الكتب والترجمات منذ رفاعة الطهطاوي وطبقته وطبقة تلاميذه قد ساهمت في ارتفاع الوعي بأحوال العالم، خصوصا ما كان منها في شأن السياسة والتاريخ (فقد شهد هذا القرن ثلاث موجات للثورة الفرنسية). كذلك فقد أخذت الصحافة هامشا واسعا من الحرية وانتشرت المطابع مما أتاح انتشارا أوسع لتيارات فكرية نابعة من المجتمع لا معبرة عن السلطة.
3. وفي المؤسسات استمر الاحتكار السلطوي والنفوذ الأجنبي، ولكن مع زيادة طبقة مصرية وسطى متعلمة تساهم في إدارة هذه المؤسسات، مما يجعل الأمر أفضل قليلا من نهاية عصر محمد علي.
4. وزادت قوة المجتمع في مؤسسة التشريع والقانون، وذلك من خلال محاولة الخديو إسماعيل تقليد السياسة الغربية بإنشاء مجلس للنواب له صلاحيات واسعة في مسائلة الحكومة ومراقبتها، وقد كان هو محتاجا إلى هذا المجلس ليمثل حماية له من الضغوط الأجنبية التي زادت عليه بعد إسرافه في الاستدانة من المصارف وبيوت المال الغربية.
وبمجموع هذه العوامل قامت الثورة العرابية التي بدأت بحركة احتجاج داخل الجيش على معاملة الضباط المصريين وحقهم في المناصب العليا، ولكنها تفاعلت مع المطالب المجتمعية المختلفة التي شملت أمور الضرائب والسيطرة الأجنبية على الاقتصاد والنهضة الفكرية والروح الثورية التي أطلقها الأفغاني وتلاميذه، واستطاعت الثورة العرابية أن تحمل هذه المطالب وأن تنتصر في كثير من المواقع مع الخديو فأجبرته على تغيير الوزارة (فجاء الباردوي رئيسا وعرابي وزيرا للجهادية) وعلى القبول بمجلس نواب طبقا للائحة 66، وأقر ذلك في فبراير 1882م.
وقد تغيرت النسبة بين قوة المجتمع وقوة الدولة، فإجمالا يتبين أن المجتمع امتلك (41%) من عوامل القوة، بينما امتلكت السلطة (59%) منها. على نحو ما يظهر في هذا الشكل:
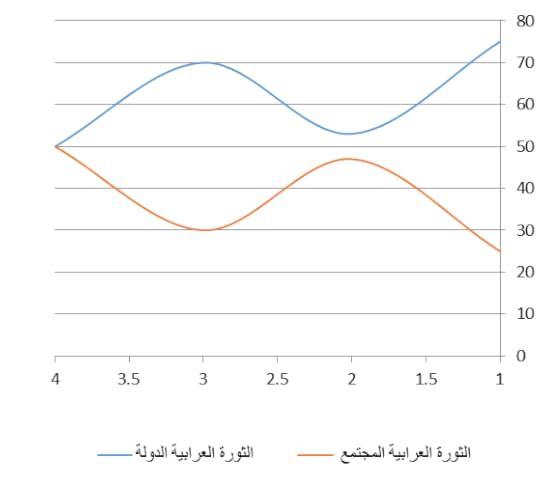
1 القوة المسلحة 2 صناعة الوعي 3 المؤسسات التنفيذية والثروة 4 التشريع والقانون
وكانت هذه النسبة من الخطورة بمكان، إلى الحد الذي لم يعد فيه من بديل إلا التدخل الغربي المباشر بالاحتلال الإنجليزي، فافتعلت مشكلات بالإسكندرية نزل على إثرها الأسطول البريطاني فيها بدعوى حماية الأجانب والمصالح الأجنبية، وانتهت الثورة العرابية إلى الفشل أمام الهزيمة العسكرية.
وهنا يظهر من جديد أن احتكار الدولة للسلاح كان من أسباب الضعف والهزيمة، إذ ما إن انهزم الجيش الرسمي للدولة حتى انهارت الدولة أمام الاحتلال، على العكس من الوضع أيام الغزو الفرنسي، كما أن القيادات الفكرية والعملية التي ساهمت في التوجيه لم يكن لها من العمق والرسوخ الاجتماعي (بأثر النظام الجديد الذي أسس له محمد علي) ما كان للعلماء والزعماء ومشايخ الطرق الصوفية ونقباء المهن والحرف في العصر العثماني المملوكي، كذلك فقد استسلمت المؤسسات التي تدير الثروة للاحتلال لكثرة الأجانب في مراكزها القيادية مما منع تكون مقاومة اجتماعية.
وبهذا لما استطاعت الدولة احتكار مسارات القوة والتأثير وصار المجتمع مجبرا على تمثيل نفسه من خلال مؤسسات الدولة الرسمية، لم يكن ثمة مقاومة شعبية بعدما انهارت الدولة.
نشر في ساسة بوست
شهد المجتمع المصري تطورا فارقا في القرنين الأخيرين بداية منذ الحملة الفرنسية على مصر وحتى اللحظة الحاضرة. ويمكن تقسيم هذه الحقبة إلى ثماني فترات، هي:
1. قبل الحملة الفرنسية2. الحملة الفرنسية3. عصر محمد علي 4. عصر الأسرة العلوية5. الاحتلال الإنجليزي6. ثورة 1919 ونتائجها7. حقبة العسكر8. ثورة يناير
بلغت صفحات هذه الدراسة نحو ثلاثمائة صفحة، ويتوقع أن تصدر قريبا إن شاء الله، ثم آثرنا تقديم خلاصتها في مقالات منشورة، فهذه المقالات هي بمثابة تهذيب التهذيب أو خلاصة الخلاصة، لتعميم الفائدة.
تركز الدراسة على المقارنة بين "قوة الدولة" و"قوة المجتمع" في هذه العهود المختلفة، وقد خلصت إلى نتائج من أهمها أن لحظات التقدم هي لحظات التوازن بين هاتين القوتين، بينما لحظات الضعف والهزيمة هي اللحظات التي زاد فيها تغول وتوحش الدولة على حساب إضعاف وكسر المجتمع، وأن تمكين المجتمع هو المشروع الذي حملته الثورات وحركات النهضة والإحياء بينما كان تقوية الدولة هو المشروع الذي حمله الاحتلال وعملاء الاحتلال.
وحددت الدراسة عوامل القوة في أربعة عناصر:
(1) السلاح: الذي يمثل قوة الردع أو قوة الإجبار والتنفيذ.(2) الوعي: الذي يمثل المفاهيم والمبادئ والقيم الحاكمة.(3) إدارة الثروة (المؤسسات): وهي المؤسسات التي تدير ثروات ومقدرات البلد.(4) التشريع والقانون: وهي التي تعبر عن القيم والإجراءات الحاكمة ونظام إنفاذها.
وسَعَتْ الدراسة للنظر في كل عنصر من هذه العناصر لرصد توزعه بين الدولة والمجتمع، وخرجت بتقريبات رقمية لهذه النسبة، وضعتها في رسوم بيانية لشرح مسار تطور المجتمع المصري بشكل أفضل بصريا.
وقد اعتبرت الدراسة أن القوة متوزعة بالتساوي بين هذه العناصر الأربعة، وذلك لطول الأمد (أكثر من قرنين من الزمان) مع الاعتراف بأن "السلاح" هو الأعلى والأهم في المراحل الفاصلة، يليه بقدر ما "الوعي"، ولكن مراحل السلم والاستقرار يكون العنصر الأهم هو "المؤسسات والثروة" و"التشريع والقانون" ويليهما الوعي والسلاح.
وحيث اعتمدت الدراسة أسلوب التبسيط ورسم المسارات العامة، فقد جعلنا نسبة القوة متوزعة بالتساوي بين هذه العناصر الأربعة، باعتبار أن الفترة المدروسة تنوعت بين سلم وحرب، وبين اضطراب واستقرار مما يحذف أثر القوة النسبية لعنصر من العناصر في لحظة من اللحظات.
واعتمدت الدراسة منهجا لتحليل كل عنصر من عناصر القوة على هذا النحو الآتي:
أولا: السلاح
السلطة المجتمع 100 نقطة امتلاك السلاح
20 نقطة الفارق في قوة السلاح
20 نقطة قرار استخدام السلاح
20 نقطة نسبة المرتزقة إلى المجتمع في القوات النظامية
20 نقطة نسبة المشاركة في مقاومة العدوان الخارجي
20 نقطة
ثانيا: الوعي
السلطة المجتمع 100 نقطة التحكم في إدارة المؤسسات التعليمية
20 نقطة التحكم في تمويل المؤسسات التعليمية
20 نقطة التحكم في المعلمين
20 نقطة التحكم في المؤسسات الدعوية
20 نقطة التحكم في المطبوعات ومصادر المعلومات
20 نقطة
ثالثا: المؤسسات والثروة
السلطة المجتمع 100 نقطة نسب توزع الثروة
50 نقطة نسب التحكم في الثروة
50 نقطة
رابعا: التشريع والقانون
السلطة المجتمع 100 نقطة امتلاك مؤسسات التشريع "إصدار القوانين"
25 نقطة امتلاك مؤسسات "القضاء"
25 نقطة السيطرة على المصادر المالية لمؤسسات التشريع والقضاء
25 نقطة الإمداد بالكوادر البشرية للمؤسستين
25 نقطة
وقد اعتمدنا التساوي في النقاط بين أدوات القياس لكل عنصر لضرورة التبسيط، لأن الدراسة تهدف إلى رسم ملامح الصورة العامة، ويحتاج التوزيع الدقيق للنسب إلى عمل أكثر عمقا وتعقيدا. كذلك اعتمدنا رفع النقاط إلى (100) لمزيد من الوضوح في التحليل، والذي سيظهر أوضح ما يكون عند رسم الشكل البياني.
في هذه الخلاصة لن نعرض إلا الرسوم البيانية الأخيرة التي تقارن بين قوة السلطة وقوة المجتمع.
(1)ما قبل الحملة الفرنسية
كان التوازن قائما في توزيع القوى بين الدولة وبين المجتمع:
1. فقد تفوقت الدولة على المجتمع في قوة السلاح وكثرته وامتلاكها قرار استخدامه، وبهذا كانت متكفلة بصد العدو الغازي، إلا أنها لم تكن تحتكره بل كان المجتمع يمتلك قدرا وافرا منه، خصوصا في الصعيد الذي كان يتمتع بنوع من الاستقلال الذاتي.
2. بينما تفوق المجتمع على الدولة في صناعة الوعي، ذلك أنه لم يكن بيد السلطة وسيلة مركزية لنشر الأفكار والمعلومات وصناعة وعي موحد للجماهير، كما أن السلطة لم تكن متدخلة في أمور التعليم الذي كان يديره المجتمع بشكل شبه كامل، فكانت المدارس والمساجد ينفق عليها من الأوقاف، ويديرها العلماء وطلبة العلم في ظل غيبة شبه كاملة من السلطة عن التمويل والإدارة لهذه المؤسسات. فحتى الأغنياء وأصحاب رأس المال يتوقف تحكمهم عند التبرع وإنشاء المدارس ولا يصنعون مناهجها ولا يتحكمون في توجيهها.
3. وتحقق نوع من التوازن، مع تفوق للدولة في مسألة المؤسسات وإدارة الثروة، فقد اقتصرت وظيفة السلطة على إدارة ملفات الأمن والدفاع، بينما ظلت باقي المؤسسات تحت إدارة المجتمع، مثل نظام الحرف والمهن الذي كان يمثل بيئة تكافلية ورابطة اجتماعية، ولم تكن الدولة تتحكم فيه ولا تديره.
4. كما تحقق نوع من التوازن، مع تفوق للمجتمع في مسألة التشريع والقانون، إذ لا تتدخل السلطة في التشريع، بل ظلت الشريعة الإسلامية مهيمنة على مجال التشريع والتقنين، وهي وظيفة يمارسها العلماء والقضاة بشكل أساسي، ويقتصر دور السلطة على تقنينات تفصيلية وإجرائية. كذلك فقد كانت مؤسسة القضاء مستقلة ماليا إذ تعتمد على الأوقاف، ولم تكن السلطة العثمانية تعين سوى 5 من بين 36 منصبا قضائيا. وكانت للقوى الاجتماعية (العلماء، القضاة، الزعماء) أدوار فاعلة في الاعتراض على السلطة وتمثيل المجتمع أمامها، فكانوا كالطبقة بين الحكام والعامة.
الخلاصة:
تفوقت الدولة على المجتمع في مجال السلاح بفارق كبير، مما أدى لسرعة انهيارها أمام الغزو الفرنسي، إلا أن وجود قوى اجتماعية فاعلة وامتلاكها لعوامل قوة مؤثرة في المجتمع مكنها من سرعة أن تحل بديلا عن الدولة وأن تبدأ مقاومتها ضد الغزو الفرنسي.
وبحساب مجموع القوى بين الدولة والمجتمع نرصد أن المجتمع امتلك حوالي (47.7%) من ميزان القوة، بينما امتلكت السلطة (52.3%) منها.
ويتضح شكل توزع القوى بين الدولة والمجتمع من خلال هذا الرسم البياني:
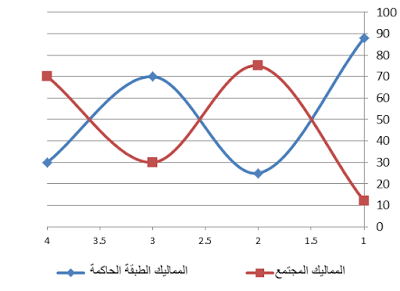 1 القوة المسلحة 2 صناعة الوعي 3 المؤسسات التنفيذية والثروة 4 التشريع والقانون (2)الحملة الفرنسية
1 القوة المسلحة 2 صناعة الوعي 3 المؤسسات التنفيذية والثروة 4 التشريع والقانون (2)الحملة الفرنسية
ما إن انهارت السلطة المملوكية بهزيمة جيش إبراهيم ومراد بك أمام الجيش الفرنسي حتى ظهرت القوة الشعبية لتجاهد المحتل، وقد فاضت الكتب التي أرخت لذلك الوقت بالمقاومة الباسلة المستمرة من المصريين للغزاة الفرنسيين، وبرغم الفارق الهائل في القوة فقد سارت المعارك بحيث تبدو وكأنها بين جيشين متكافئين، وقد حقق المصريون انتصارات غالية مع فارق هائل في أعداد الشهداء منهم مقابل أعداد القتلى من الفرنسيين. وقُدِّر عدد الشهداء بمئات الآلاف في وقت كان تعداد المصريين فيه مليونين فقط.
ومثلما انهار ملف "الدفاع" الذي كان بيد السلطة، انهار ملف "الأمن" أيضا بزوال هذه السلطة، وسارت حالة من الهجرة الجماعية لمن استطاع من مصر، وصحب ذلك عمليات نهب وسلب وإغارات واسعة، كل ذلك في أول فترة العدوان الفرنسي.
وصار الحال على هذا النحو في ميزان استعمال القوة حسب العناصر الأربعة:
1. كثر السلاح بأيدي المجتمع بما فقدته السلطة المملوكية من أسلحة، وبما استعملوه في معاركهم مع الفرنسيين، وبما غنموه منهم، وبما أعادوا تصنيعه في حمأة المقاومة، مع بقاء الفارق الهائل بين الطرفين في قوة السلاح، ولكن تساوى الطرفان في القدرة على استعمال السلاح وفي قرار استعماله. مما أحدث نوعا من التوازن في معركة "القوة المسلحة" بين الطرفين.
2. وفشل الفرنسيون تماما في "معركة الوعي" رغم محاولاتهم المضنية، وظلت القيادة الفكرية للمجتمع قائمة في شيوخ الأزهر ومشايخ الطرق الصوفية وزعماء القبائل ونقباء الحرف والمهن، فظل هؤلاء على موقعهم القديم من تمثيل المجتمع وقيادته، فكان المجتمع أقوى من السلطة الفرنسية في تكوين وعي الجماهير.
3. بينما تفوق الفرنسيون –من موقعهم كسلطة احتلال- في التحكم في الثروة، فقد ضاعفوا من الضرائب على المصريين، وحاولوا السيطرة على الأوقاف من خلال أن عهدوا بإدارتها للنصارى من القبط والشوام، فاتخذها أولئك كالمغنم وتعطلت رواتب كثير من العلماء والمؤذنين والفقهاء والعميان والمرضى وغيرهم. وأسسوا كذلك لجمعية تمثيلية تكون كالمحلل للمحتل من خلال التمثيل السياسي للمجتمع، إلا أن عدم الثقة فيهم جعلت الفرنسيين لا يعطونهم صلاحيات حقيقية.
4. فيما بقيت مؤسسات التشريع والقانون على حالها تقريبا، ذلك أن قصر الفترة التي قضاها الفرنسيون في مصر، وامتلائها بالمقاومة والاضطرابات، وحاجتهم إلى مهادنة فئات من الشعب المصري خصوصا في هذه المسائل الحساسة، كل ذلك حال دون إجراء كثير تغيير في هذه المؤسسات، فبقي المجتمع محتفظا بتفوقه فيها.
الخلاصة:
عمل الاحتلال الفرنسي على تقوية سلطة الدولة وكسر المجتمع، وكانت أول محاولة لكسر وتغيير أنظمة المجتمع من خلال تحطيم أبواب الحارات ومحاولة التحكم في الأوقاف وصناعة تمثيل سياسي، إلا أنه لم ينجح في ذلك، ولما لم تطل فترة بقائه في مصر فإنه عجز عن تفكيك القوى الاجتماعية التي قادت المقاومة، ومثلت بديلا حقيقيا عن سلطة المماليك بعد انهيارها.
وبحساب مجموع القوى بين الدولة والمجتمع نرصد أن المجتمع امتلك حوالي (61%) من ميزان القوة، بينما امتلكت السلطة (39%) منها، وأبلغ دليل على قوة المجتمع هو قدرتهم على فرض محمد علي واليا عليهم رغما عن السلطان العثماني.
ويتضح شكل توزع القوى بين الدولة والمجتمع من خلال هذا الرسم البياني:

1 القوة المسلحة 2 صناعة الوعي 3 المؤسسات التنفيذية والثروة 4 التشريع والقانون
(3)عصر محمد علي
وهو العصر الذي أعيد فيه تشكيل المجتمع المصري، إذ غُرِس نظام الدولة الحديثة بديلا عن النظام الإسلامي، وتغيرت وجوه العلاقات بين المجتمع والسلطة، وتأسس وضع جديد تماما، بالقهر وبالسيف، حتى كانت مصر بعد محمد علي شيئا مختلفا عنها من قبله.
ومن خلال عناصر القوة الأربعة التي نتناولها بالبحث سنرى كيف حطم محمد علي النظام القائم، واستبدل به نظام "الدولة الحديثة" التي تتغول فتشمل كل شيء وتتحكم في كل شيء.
1. ففي جانب السلاح قرر محمد علي تجريد الشعب من السلاح وجعله محتكرا بيد الدولة وحدها، ولم يعطله عن هذا أن المجتمع المسلح استطاع صد الاحتلال الإنجليزي (حملة فريزر 1807) بل أصر أكثر على ألا يبقى "السلاح في يد الفلاحين". وأسس جيشا على النظام الحديث وبإشراف من خبير فرنسي، سلك فيه ذات المسلك الأوروبي في الاستعباد ومعاملة الجنود كأنهم عبيد، ونزعهم من كل قيمة إنسانية أو أخلاقية وزرع تقديس الأوامر العسكرية.. فظهر بهذا أول جيش ليس له مرجعية إسلامية عليا. وهذا بخلاف الإجراءات التي استعملت في التجنيد وفي الحد من التهرب وفي التدريب، وهي إجراءات غربية بحتة خالية من كل قيمة أو ضوابط إسلامية. بل يمكن القول بأن "البناء الإحصائي والبيروقراطي" للدولة المصرية إنما كان لأجل الجيش بالأصل. وذات الكلام يُقال في الشأن الأمني، فقد كان من بدايات الإجراءات التي اتخذها محمد علي اختراع مناصب أمنية، ووصل في التحكم إلى حد منع التنقل بين القرى إلا بتصريح مرور.
2. وفي جانب الوعي والقيادة الفكرية شن محمد علي حملة عنيفة لكسر جميع القيادات الفكرية والزعامات الاجتماعية، وشمل بالإقصاء –قتلا ونفيا وتحجيما ومطارة- كافة القيادات: العلماء، ومشايخ الطرق الصوفية، زعماء القبائل ورؤوس العائلات الكبيرة، نقباء المهن والحرف، حتى قال الشيخ محمد عبده "لم يترك في بر مصر رأسا يقول: أنا". وأنشأ المدارس على النظام الأوروبي الحديث فدخل بذلك نظام للتعليم يخالف ويزاحم النظام الأزهري، وأنشأ المطابع التي كانت مملوكة للدولة ومن هنا بدأت تعلو يد الدولة وقدرتها على صناعة وعي موحد. إلا أن التعليم الأزهري بقي ولم يختفِ وظلت للمشايخ قدرة نسبية على توجيه الوعي وصناعته وإن كانت أضعف بكثير من ذي قبل.
3. واستطاعت دولة محمد علي أن تنشئ مؤسسات قاهرة تتحكم في الإدارة والسلطة، فقد كان نظامه المركزي القائم على إعادة التحكم في الزراعة والري والصناعة قد أنهى بشكل عملي نظام نقابات المهن والحرف والوظائف، وأنهى الوضع التكافي الاجتماعي القديم لحساب اتخاذ كل هذه الأنشطة كأدوات وعناصر تخدم في جهاز الدولة وضمن خطتها العامة (والوحيدة بالطبع). ثم كانت ضربته الهائلة الكبرى والتي لم يستطعها أحد من قبله باستيلاء الدولة على الأوقاف ومنح السلطة لنفسها الحق في الإشراف على إدارة الأوقاف وأخذ ريعها وإعادة إنفاقها في مصارفها.
4. وبدأت في عهد محمد علي بذرة تدخل الدولة في مؤسسات التشريع والقضاء، فظهرت مؤسسات تزاحم القضاء الشرعي، مثل "المجالس القضائية" التي صارت إليها مهمة التشريع ووضع القوانين، لكن ظلت الهيمنة العامة للقضاء الشرعي، مما يجعل هذه النقطة نقطة توازن وحيدة بين السلطة والمجتمع في عصر محمد علي.
الخلاصة:
تغولت الدولة على حساب المجتمع في كل عناصر القوة باستثناء الرابع "التشريع والقانون"، وعاش الشعب المصري واحدة من أقسى لحظات تاريخه في استبداد السلطة.
وبحساب مجموع القوى بين الدولة والمجتمع نرصد أن المجتمع امتلك حوالي (24%) من ميزان القوة، بينما امتلكت السلطة (76%) منها.
ويتضح شكل توزع القوى بين الدولة والمجتمع من خلال هذا الرسم البياني:

1 القوة المسلحة 2 صناعة الوعي 3 المؤسسات التنفيذية والثروة 4 التشريع والقانون
(4)عصر الأسرة العلوية
يعد عصر الأسرة العلوية (منذ نهاية حكم محمد علي وحتى الاحتلال الإنجليزي) امتدادا للنظام الذي أسسه محمد علي، وقد ظلت عوامل القوة كما هي في عصر محمد علي:
1. فقد استمر السلاح محتكرا بيد الدولة، وليس للمجتمع حق فيه.
2. واستمرت القيادة الفكرية والتوجيهية حصريا للدولة التي امتلكت المطبعة والصحف كوسائل صناعة وعي مركزية.
3. بينما قلت نسبة إدارة السلطة للثروة بقدر بسيط، وزادت نسبة مشاركة المجتمع، وذلك بعد قرارات الخديو سعيد بتخفيض الضرائب على الفلاحين وإعطائهم الحق في تملك الأراضي من بعد ما كانت احتكارا حصريا للباشا والأسرة الحاكمة، كذلك فقد سمح الخديو سعيد للمصريين بالترقي إلى المراتب العليا في الجيش، وكان هذا إصلاحا سيكون له أثر بعيد في حدوث الثورة العرابية.
4. لكن الأزمة الكبرى كان في جانب مؤسسات التشريع والقانون، إذ زاد الجور على حق الشريعة والمحاكم الشرعية لحساب القوانين الوضعية، إذ شهدت هذه الفترة استيراد قوانين فرنسية، وإنشاء المحاكم القنصلية الأجنبية، ثم المحاكم المختلطة، وقد كان هذان النوعان من المحاكم تحت السيطرة الكاملة للأجانب الذين تدفقوا على مصر في عصر محمد علي وأبنائه، وفقدت مصر استقلالها التشريعي (ولم تستعده جزئيا ونظريا إلا في معاهدة 1936 وعمليا في 1949، أي مدة قرن من الزمان).
ولهذا، ففي الوزن الأخير لعوامل القوة، نجد أن النسبة لم تتغير كثيرا، فقد امتلك المجتمع (23%) من عوامل القوة، بينما امتلكت السلطة (77%).
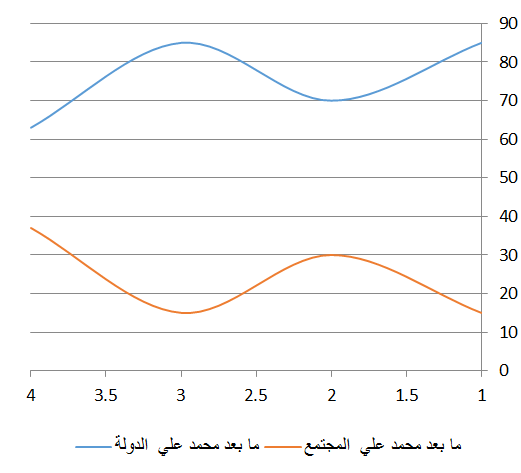
1 القوة المسلحة 2 صناعة الوعي 3 المؤسسات التنفيذية والثروة 4 التشريع والقانون
في أواخر عصر الأسرة العلوية (ما قبل الاحتلال الإنجليزي) طرأت عدة تغيرات على واقع المجتمع المصري، فتغيرت معها أوزان القوة النسبية بين المجتمع والسلطة على هذا النحو:
1. ففي مجال القوة المسلحة، أتاح زيادة عدد المصريين في الرتب العليا للجيش من نزوع هذا الجيش نحو أن يكون تعبيرا عن المجتمع لا عن السلطة كما هو الحال في ظل سيطرة العناصر الأجنبية (والتي هي في حكم المرتزقة لانفصالها عن المجتمع طبقيا وعرقيا ولغويا وثقافيا). وكان هذا الانقسام المصري الأجنبي في صفوف الجيش يُحسم في كثير من الأحيان لصالح المصريين.
2. وظهرت في المجتمع المصري قيادات فكرية جديدة بروح جديدة، أبرزها: جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده، وعبد الله النديم وغيرهم، وقد أثار هؤلاء روحا جديدة بين الشيوخ والعامة تحرضهم على الثورة ضد الاستبداد. وكان لهم أثر فكري وعملي بعيد. ولا ريب أن انتشار التعليم وما انتشر من الكتب والترجمات منذ رفاعة الطهطاوي وطبقته وطبقة تلاميذه قد ساهمت في ارتفاع الوعي بأحوال العالم، خصوصا ما كان منها في شأن السياسة والتاريخ (فقد شهد هذا القرن ثلاث موجات للثورة الفرنسية). كذلك فقد أخذت الصحافة هامشا واسعا من الحرية وانتشرت المطابع مما أتاح انتشارا أوسع لتيارات فكرية نابعة من المجتمع لا معبرة عن السلطة.
3. وفي المؤسسات استمر الاحتكار السلطوي والنفوذ الأجنبي، ولكن مع زيادة طبقة مصرية وسطى متعلمة تساهم في إدارة هذه المؤسسات، مما يجعل الأمر أفضل قليلا من نهاية عصر محمد علي.
4. وزادت قوة المجتمع في مؤسسة التشريع والقانون، وذلك من خلال محاولة الخديو إسماعيل تقليد السياسة الغربية بإنشاء مجلس للنواب له صلاحيات واسعة في مسائلة الحكومة ومراقبتها، وقد كان هو محتاجا إلى هذا المجلس ليمثل حماية له من الضغوط الأجنبية التي زادت عليه بعد إسرافه في الاستدانة من المصارف وبيوت المال الغربية.
وبمجموع هذه العوامل قامت الثورة العرابية التي بدأت بحركة احتجاج داخل الجيش على معاملة الضباط المصريين وحقهم في المناصب العليا، ولكنها تفاعلت مع المطالب المجتمعية المختلفة التي شملت أمور الضرائب والسيطرة الأجنبية على الاقتصاد والنهضة الفكرية والروح الثورية التي أطلقها الأفغاني وتلاميذه، واستطاعت الثورة العرابية أن تحمل هذه المطالب وأن تنتصر في كثير من المواقع مع الخديو فأجبرته على تغيير الوزارة (فجاء الباردوي رئيسا وعرابي وزيرا للجهادية) وعلى القبول بمجلس نواب طبقا للائحة 66، وأقر ذلك في فبراير 1882م.
وقد تغيرت النسبة بين قوة المجتمع وقوة الدولة، فإجمالا يتبين أن المجتمع امتلك (41%) من عوامل القوة، بينما امتلكت السلطة (59%) منها. على نحو ما يظهر في هذا الشكل:
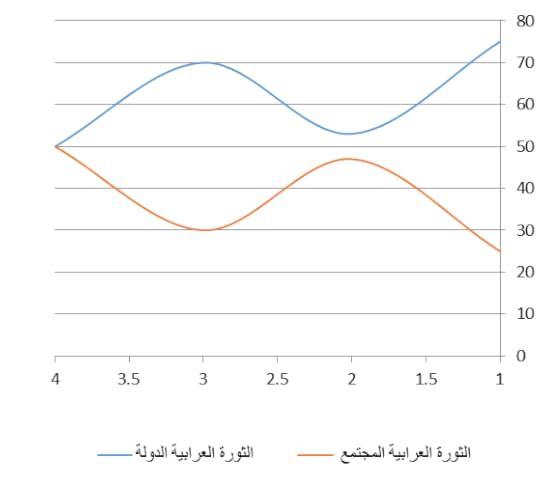
1 القوة المسلحة 2 صناعة الوعي 3 المؤسسات التنفيذية والثروة 4 التشريع والقانون
وكانت هذه النسبة من الخطورة بمكان، إلى الحد الذي لم يعد فيه من بديل إلا التدخل الغربي المباشر بالاحتلال الإنجليزي، فافتعلت مشكلات بالإسكندرية نزل على إثرها الأسطول البريطاني فيها بدعوى حماية الأجانب والمصالح الأجنبية، وانتهت الثورة العرابية إلى الفشل أمام الهزيمة العسكرية.
وهنا يظهر من جديد أن احتكار الدولة للسلاح كان من أسباب الضعف والهزيمة، إذ ما إن انهزم الجيش الرسمي للدولة حتى انهارت الدولة أمام الاحتلال، على العكس من الوضع أيام الغزو الفرنسي، كما أن القيادات الفكرية والعملية التي ساهمت في التوجيه لم يكن لها من العمق والرسوخ الاجتماعي (بأثر النظام الجديد الذي أسس له محمد علي) ما كان للعلماء والزعماء ومشايخ الطرق الصوفية ونقباء المهن والحرف في العصر العثماني المملوكي، كذلك فقد استسلمت المؤسسات التي تدير الثروة للاحتلال لكثرة الأجانب في مراكزها القيادية مما منع تكون مقاومة اجتماعية.
وبهذا لما استطاعت الدولة احتكار مسارات القوة والتأثير وصار المجتمع مجبرا على تمثيل نفسه من خلال مؤسسات الدولة الرسمية، لم يكن ثمة مقاومة شعبية بعدما انهارت الدولة.
نشر في ساسة بوست
Published on April 08, 2016 23:27
April 5, 2016
موجز قصة أردوغان
ولد أردوغان (26 فبراير 1954م) في أسرة فقيرة تسكن حي قاسم باشا وهو من أفقر أحياء اسطنبول، وكان والده قبطانا بحريا قد استقر به المقام في هذا الحي مهاجرا من قريته ريزه في الشمال التركي على ساحل البحر الأسود، وظل أردوغان في حي قاسم باشا حتى أتم دراسته الثانوية التي قضاها في مدارس الأئمة والخطباء إذ كانت تلك رغبة أبوه المعروف بالتدين حتى كان أهل قريته يضعون عنده أماناتهم ويستودعونه أموالهم، وكان حي قاسم باشا من الأحياء التقليدية التي تسود فيها قيم وتقاليد المجتمعات الشرقية القديمة كقوة العلائق بين الناس وشيوع الحمية والمروءة والحسبة الاجتماعيةأحب أردوغان كرة القدم وتنقل بين أكثر من نادٍ وفريق، وكاد يدخل إلى مرحلة احترافها لولا الرفض القاطع لأبيه، ثم تخرج (1981م) في معهد علوم الاقتصاد والتجارة، والذي صار بعدئذ كلية الاقتصاد والتجارة بجامعة مرمرة، وعمل بعدها موظفا في البلديةبدأ أردوغان مسيرة نشاطه منذ الخامسة عشرة من عمره، فقد التحق وقتها عضوا باتحاد الطلبة الأتراك بمدارس الأئمة والخطباء الذي كان حينئذ في أخصب فتراته الثقافية والتربوية، وحين تفتح وعيه السياسي كانت الساحة التركية تشهد صولات المحاولة الإسلامية الأقوى ورجلها الأشهر: نجم الدين أربكان، فحين كان أردوغان في السادسة عشرة من عمره كان أربكان يؤسس حزب النظام الوطني، وحين كان في السابعة عشرة أُغلق الحزب، ثم حين كان في الثامنة عشرة كان أربكان يعود إلى ساحة السياسية بحزبه الجديد "السلامة" (1972م)، وهو الحزب الذي التحق به أردوغان وشهد تطور مسيرته السياسية، ولم تمض أربع سنوات حتى كان أردوغان رئيس جناح الشباب لحزب السلامة في اسطنبول (1976م) بفوزه في الانتخابات الداخلية لشُعَب حزب الشباب، وهو فوز انتزعه وحيدا على غير رغبة قيادة الحزب في اسطنبولوفي (1994م) كان أردوغان أقوى شخصية في حزب الرفاه بعد أربكان، وكان يشرف من موقعه الحزبي –رئيس شعبة اسطنبول- على عدد من رؤساء البلديات التي فاز فيها الحزب في الانتخابات الماضية، وأنشأ لجنة في الشعبة لإدارة المحليات لتتابع أعمال البلديات وتجمع رؤساءها لتنقل الخبرات ويُبحث في حل المشكلات، ولما حان موعد انتخابات بلدية اسطنبول الكبرى أيَّد ترشحه لها من داخل الحزب 3308 عضوا من بين 3993 كذلك أيده 70% من جمهور حزب الرفاةويعد فوز أردوغان بمنصب رئيس بلدية اسطنبول الكبرى أقوى انتصار لحزب الرفاه على مستوى البلديات في أهم محافظة تركية، وقد حقق في منصبه هذا أقوى نجاحات اقتصادية وإدارية شهدتها تركيا في تاريخها الحديث وتغير بها وجه اسطنبول وتخلصت من مشكلات مزمنة كالتلوث والقمامة والمياه والصرف الصحي والمواصلات وغيرهاسُجِن أردوغان ثلاث مرات؛ الأولى بُعيْد انقلاب 1980 لمدة أيام لتهمة التظاهر في ظل الأحكام العرفية، والثانية حين دخل في اشتباك لفظي مع رئيس المجلس الانتخابي لمحليات باي أوغلو إذ اتهمه أردوغان بالسُّكْر الذي أدى إلى التلاعب في النتائج فاتهمه بالتعدي عليه فحوكم وسُجِن لمدة أسبوع (1989)، والثالثة بعد واقعة أبيات الشعر الشهيرة التي ألقاها ضمن خطاب شعبي في ديار بكر -(12 ديسمبر 1997م) قبيل أيام من إغلاق حزب الرفاه- والتي اعتبرها خصومه دينية تحريضية، فحكم عليه بالسجن لعشرة أشهر وغرامة مالية، ثم خفف فسُجِن لأربعة أشهر، وكان وداع الناس له يوم سجنه دليل واضح على أن تركيا صار لها زعيم شعبي جديدإذا تجاوزنا الصفات القيادية التي يتمتع بها الزعماء عادة كالقوة والذكاء والثقة والصبر والتأثير في الجماهير- تدينه؛ فقد كان وفيا لتخرجه من مدارس الأئمة والخطباء حتى أنه ألحق أبناءه الأربعة بها، ثم أكملت ابنتاه الدراسة خارج تركيا لئلا يتخليْن عن الحجاب، وتسفر كثير من عباراته في خطابات مختلفة عن أنه يطرح نفسه –أو حزبه- كامتداد للحقبة والأبطال العثمانيين وكخصم للحقبة العلمانية التي يحملها مسؤولية انحدار تركيا ويزدريها لاستخفافها بقيم الأتراك وتراثهم، وصرَّح غير مرة أمام سؤال العلمانية أنه "مسلم مخلص"، ويروي صديقه في السجن أنه كان يصلي الصبح في خمس وأربعين دقيقة، وأنه حين أُبْلِغ في السجن بمحاولة اغتيال وطلب منه أن يرتدي سترة واقية من الرصاص امتنع ثم صلى ركعتين وقال: "هكذا ارتديت السترة الواقية الحقيقية"- اهتمامه المبكر بالبُعْد الأممي؛ فقد كانت اجتماعات شعبة حزب الرفاه في اسطنبول تتجاوز دائرتها الصغيرة فتناقش –أو تقيم فعاليات لمناقشة- الموضوعات المطروحة على الساحة السياسية محليا ودوليا مثل مشكلة الأكراد ومشكلات دول البلقان وحرب الخليج الثانية والقضية الفلسطينية والجمهوريات التركية المستقلة عن الاتحاد السوفيتي المنهار والانقلاب العسكري في الجزائر مطلع التسعينيات، وتناولت كلمته التي ألقاها قُبِيْل دخوله السجن أحوال المسلمين في كوسوفا- اهتمامه بالتفاصيل الإنسانية الصغيرة مثل حضور جنازة صديق ولو في وقت عصيبوهو إلى ذلك خطيب مفوه يهتم بالخطاب العاطفي ويستدل في خُطَبه بالشِّعر، ولما سألته مؤسسة الجناح النسائي في حزب العدالة والتنمية عماذا تقرأ أوصاها بأن تقرأ كتابا في "بلاغة النبي"نشر في تركيا بوست
بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص33. Rabasa, Larrabee: The Rise of Political Islam, p. 14. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص27 وما بعدها. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص30 وما بعدها. عيسى مصطفى يوجار: محمد عاكف.. عصره وجهوده في الدعوة الإسلامية، رسالة دكتوراة لكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى، السعودية، بإشراف: محمد قطب، 1410هـ = 1989/ 1990م. ص229 وما بعدها. أحمد نوري النعيمي: النظام السياسي في تركيا، (الأردن: دار زهران، 2011م). ص170، 171. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص44 وما بعدها. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص110. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص50. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص58 وما بعدها. Cemal Karakas: Turkey, Islam and Laicism, p. 24. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص136. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص130، 138، 139. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص164 وما بعدها؛ Cemal Karakas: Turkey, Islam and Laicism, p. 24. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص184 وما بعدها. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص257. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص66 وما بعدها، 237 وما بعدها، 270؛ Cemal Karakas: Turkey, Islam and Laicism, p. 31 وصفته برقية للسفارة الأمريكية في تركيا (2004م) بأنه يتبنى مواقف تتسم "بالزهو المتعجرف" ويمتلك طموحا لا حدود له ينبع من الاعتقاد بأن الله قد اصطفاه لقيادة تركيا، كما يملك "نزعة انعزالية متسلطة". كِرِم أوكْتِم: الأمة الغاضبة ص201. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص218، 274، 289. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص88، 90، 105 وما بعدها، 270، 271. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص268، 269. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص63، 67، 70. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص276. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص88. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص166، 231، 241. عبد الرحمن تيغ وآخران: مقتطفات من خطب رجب طيب أردوغان ص98، 100، 105، 106، 108، 109، 285.
بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص33. Rabasa, Larrabee: The Rise of Political Islam, p. 14. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص27 وما بعدها. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص30 وما بعدها. عيسى مصطفى يوجار: محمد عاكف.. عصره وجهوده في الدعوة الإسلامية، رسالة دكتوراة لكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى، السعودية، بإشراف: محمد قطب، 1410هـ = 1989/ 1990م. ص229 وما بعدها. أحمد نوري النعيمي: النظام السياسي في تركيا، (الأردن: دار زهران، 2011م). ص170، 171. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص44 وما بعدها. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص110. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص50. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص58 وما بعدها. Cemal Karakas: Turkey, Islam and Laicism, p. 24. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص136. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص130، 138، 139. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص164 وما بعدها؛ Cemal Karakas: Turkey, Islam and Laicism, p. 24. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص184 وما بعدها. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص257. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص66 وما بعدها، 237 وما بعدها، 270؛ Cemal Karakas: Turkey, Islam and Laicism, p. 31 وصفته برقية للسفارة الأمريكية في تركيا (2004م) بأنه يتبنى مواقف تتسم "بالزهو المتعجرف" ويمتلك طموحا لا حدود له ينبع من الاعتقاد بأن الله قد اصطفاه لقيادة تركيا، كما يملك "نزعة انعزالية متسلطة". كِرِم أوكْتِم: الأمة الغاضبة ص201. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص218، 274، 289. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص88، 90، 105 وما بعدها، 270، 271. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص268، 269. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص63، 67، 70. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص276. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص88. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص166، 231، 241. عبد الرحمن تيغ وآخران: مقتطفات من خطب رجب طيب أردوغان ص98، 100، 105، 106، 108، 109، 285.
Published on April 05, 2016 08:09
April 4, 2016
قيمة ومعنى وجود نموذج سياسي إسلامي
ذكرنا في مقال سابق على صفحات المعهد المصري أن الفارق الرئيسي والتميز الأكبر للنموذج السياسي الإسلامي متمثل في وجود "النص المعصوم" الذي يمثل الثوابت والمركز للنموذج الحضاري، ثم في وجود عصر تحقق تاريخي يمثل "العصر الذهبي" والنموذج العملي لتطبيق هذا النموذج. واتخذنا مسألة "شرعية السلطة" كنموذج يبدو معه هذا الافتراق.
ومن ضمن التعليقات التي وصلتنا على المقال تعليق يتساءل عن الفائدة من وجود نموذج أصلا، خصوصا إذا كان هذا النموذج لم يطبق سوى ثلاثين عاما في تاريخ جاوز الأربعة عشر قرنا؟!
سأستعين في الإجابة على هذا السؤال بالدراسة المتميزة الموسعة التي أعدتها الباحثة الإيطالية ماريا لويزا برنيري حول "المدينة الفاضلة عبر التاريخ"، وفيه تتبعت أفكار الفلاسفة وتصوراتهم عن المدينة الفاضلة، منذ العصر القديم مرورا بعصر النهضة والتنوير والعصر الحديث.
(1) وجودٌ في مقابل العدم
كان أول ما خلصت إليه دراسة برنيري أنه ليس ثمة نموذج من تصورات المدينة الفاضلة قد تحقق في واقع الأرض، سواء في ذلك من تصوروا وامتلكوا سلطة التنفيذ أو من تصوروا وامتلكوا سلطة النداء والتوجيه أو من تصوروا الأمر في خيالهم فحسب.
وكثيرا ما راود الخيال الغربي فكرة نهاية التاريخ وأنهم بصدد الوصول إلى اللحظة التي يكتشف فيها البشر الطريق الأمثل لنظام حياتهم، بل هي الفكرة الجوهرية في المسيرة العلمانية (ويراجع في هذا كتابات د. عبد الوهاب المسيري) بل أعلن بعضهم في لحظات بعينها أنهم الآن عند نهاية التاريخ كما فعل فرانسيس فوكوياما عند انتصار الليبرالية وانهيار الاتحاد السوفيتي، ثم ما يلبث أن يسفر الزمن عن أن التاريخ لم ينتهِ بعد!
والفلسفة الغربية أشبه بالغابة الضخمة المشتبكة المتناقضة من الأفكار والتصورات والرؤى، وما نراه نحن في العالم العربي –لضعف الثقافة وقلة الاطلاع- ثوابت عندهم هي في الحقيقة موضوعات تهتز بشدة وتعاني من انتقادات جذرية وكاسحة، بل إن الفلسفة الغربية أنتجت مصطلح "ما بعد كذا" لتعبر عن "انتهاء" مرحلة أو فلسفة دون استيضاح ماذا سيليه.
فالخلاصة أن "وجود نموذج" يمثل القدوة في الفكر الإسلامي هو بحد ذاته إنقاذ من التيه والضياع الفلسفي الكبير الذي يؤدي إليه "عدم وجود" نموذج في الماضي، وكذلك عدم اليقين بنموذج واضح الملامح سيأتي به المستقبل.ولا يجد المرء تشبيها لهذا الوضع خيرا من قول الله تعالى {اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ} [البقرة: 257].
(2) الواقعية في مقابل النظرية
في بداية بحثها، تعترف برنيري بأن "عصرنا هو عصر التسويات والحلول الوسطى، والسعي لجعل العالم أقل شرورا. والحالمون من أصحاب الرؤى أصبحوا موضع السخرية أو الاحتقار، والناس "العمليون" هم الذين يحكمون حياتنا"، ومنذ القرن التاسع عشر بدأ انحلال "التفكير اليوتوبي" وأصيب بعدوى "الواقعية"هكذا إذن، لم تستطع تصورات المدينة الفاضلة أن ترفع من مستوى الحياة الواقعية، بل كان تأثير الواقع أشد فأنزل المثاليات النظرية من عليائها لتنتج تصورات أخرى للمدينة الفاضلة أقل حلما ومثالية.
وكانت واحدة من إشكاليات الموضوع أنهم بدلا من محاولة "اكتشاف قوانين الطبيعية، فضَّلوا أن يخترعوها أو يعثروا عليها في "سجلات الحكمة القديمة"... وبدلا من أن يقيموا يوتوبياتهم على تجمعات حية وبشر مثل أولئك الذين يعرفونهم، أقاموها على تصورات مجردة"هنا تبدو قيمة نموذج عملي واقعي تحقق في التاريخ لثلاثين سنة أمرا عظيما، فهو نموذج لم يحلق في آفاق الخيال ولم يحاول اختراع قوانين الطبيعة، بل نجح في التعامل مع واقع البشر. ولقد استمر ذلك النموذج ثلاثين سنة في قمته ثم بدأ النزول عن هذه القمة تدريجيا وببطء، لكن الأمة التي خرجت في هذه الثلاثين سنة هي الأمة التي ظلت ألف سنة تشع علما وحضارة.
فالخلاصة أن تحقق النموذج في واقع الحياة لعدد من السنين يمثل في حد ذاته القدرة على إعادة تحققه مرة أخرى، فيصير السعي إليه سعيا واقعيا، وهو خير من السعي وراء سراب تصورات حالمة لم تتحقق ولم تستطع أن تخرج من سطور الكتب إلى التعامل مع واقع الناس.
(3) الوضوح في مقابل التناقضات
إذا صار لدينا نموذج عملي متحقق في واقع الناس، أثمر ذلك نجاة من الاشتباكات والتناقضات في تحديد النموذج المعرفي والكليَّات الكبرى، فلن تصير الأمة ضحايا للأفكار التي تمثل ردات فعل على واقعها بالمقام الأول، إذ لن تضطر لدخول صراعات دموية للخروج من عصر الإقطاع إلى عصر الشيوعية أو من عصر الشيوعية إلى عصر الليبرالية أو من عصر الكنيسة إلى عصر الدولة.. وهكذا!
إن وجود النموذج العملي هو ما يحدد أمورا كثيرة هي من كُليَّات وأصول النظام المعرفي، مثل المرجعية النهائية وتفاعلها مع الوقائع التفصيلية المستجدة، ومثل الانحياز بين الفردية والجماعية، بين المادية والروحية، وما ينبثق عن كل هذا من أنظمة وأنماط اقتصادية واجتماعية وغيرها.
ثم إن طول فترة النموذج –وهو في حالته المثالية- لتبلغ ثلاثين سنة يسمح بوجود الكثير من الأحداث والتقلبات التي تسفر في النهاية عن وجود نموذج ثري.
وإن أول وأهم ما في هذا النموذج الراشدي هو أنه نموذج لبشر يحكمون بشرا، ليسوا آلهة ولا رسولا ولا كهنة يتصل أحدهم بالسماء، وهو ما يجعلها تجربة بشرية خالصة في التطبيق وإن كانت مرجعيتها سماوية ربانية، لكن الحاكم والمحكوم وكافة المتأثرين بالنظام يعرفون أنهم محكومون بنظام يجتهد فيه البشر للبشر.
ولقد شهدت هذه الثلاثون عاما التقلبات التي تمر بالدول كلها، بدءا من مخاضات التأسيس (في عهد أبي بكر) ثم مرحلة التوسع والنمو والنضج (في عهد عمر) ثم الرخاء والازدهار (عهد عثمان) ثم الفتن الداخلية (أواخر عهد عثمان إلى عهد الحسن بن علي)، مع ما شهده كل هذا من تعديلات في بنية النظام وانتقال للسلطة وتأسيس للمؤسسات وسياسة للأموال وتعامل مع المعارضة السلمية والمسلحة... وغير ذلك!
وكل هذه الأمور وغيرها تختلف العقول بشأنها إن غاب النص وغاب النموذج التطبيقي له، وإن الأمة التي تسعى لاستعادة نموذج سبق وتعامل مع الأوضاع السياسية لهي أكثر بصيرة وأوضح طريقا من أمة تبحث عن نموذج لم تر ملامحه ولا تحسم كثيرا من أسئلته الجوهرية.
(4) روح الحضارة الإسلامية
ونختم المقال بضرب المثال:
إن المسلمين يؤمنون بأن عصر الخلافة الراشدة هو القدوة التي يتمثلونها، ولهذا آثار ضخمة على مستوى التصور وعلى مستوى التطبيق، وقد ضربنا في المقال السابق مثلا بالحاكم المسلم الذي يظل عبر التاريخ يُحاكم إلى نماذج الخلفاء الراشدين باعتبارهم المثال الذي ينبغي تجديده، ولقد يكون الحاكم المسلم أنجز –بالمعيار الدنيوي- إنجازا عظيما لكن جمهرة الفقهاء والمؤرخين لا يرضون عنه، وهو هو نفسه الذي لو كان في سياق غربي لكان بغير شك من عظماء مؤسسي الدول، وذلك لأن وجود نموذج في النظام الإسلامي يمثل الحق الذي يعلو على القوة، وانعدام هذا النموذج في السياق العلماني يؤدي لأن تكون القوة هي معيار الحق.
الآن نضرب مثالا آخر لآثار الإيمان بنموذج الخلافة الراشدة، هو أن روح الحضارة الإسلامية تنحاز إلى الإنسان لا إلى البنيان، وإلى المعنى أكثر من المادة.
لقد انتهى عصر الخلافة الراشدة، الذي هو العصر الذهبي في الذهن الإسلامي، ولم يكن للمسلمين قصور مشيدة ولا بيوت فاخرة ولا مباني ضخمة ولا مساجد مزخرفة ولا ثياب مزينة.. لقد أتى هذا كله فيما بعد، في العصور التي لا تمثل قدوة. إلا أن هذا العصر كان هو عصر الإنسان، العصر الذي يأمن فيه الإنسان على نفسه وعرضه وأهله، لا يستطيع حاكم أن يستذله أو يقهره أو يخيفه أو يظلمه، عصر تستطيع فيه المعارضة أن تواجه الخليفة قولا وصراخا وبالسلاح أحيانا ثم يكون لهم بعد هذا حقوق لا ينتقص منها.
إن الذي ينتقص من عصر الخلافة لأن ثلاثة من خلفائه قُتِلوا ينسى أن الذين قُتلوا لم يُقتلوا لظلم وقع منهم وإنما لاتساع هامش المساحة الممنوحة للجميع، لقد استطاع العبد الفارسي أن يهدد عمرا قبل أن يقتله ويحيا في المدينة لا يمسه سوء، ثم استطاع هذا العبد أن يصلي في الصف الأول خلف عمر وأن يطعنه، وحاصر المتمردون بيت عثمان وهو من حماهم ومنع أصحابه من مقاتلتهم والتصدي لهم بعد مجهود وافر في بيان ما هم عليه من الباطل والدفاع عن نفسه، وكان من قبل ذلك قد تعرض لمحاولة اغتيال فلم يعاقب أصحابها باعتبار أن الجريمة لم تقع فلا يستحقون عقابا، وقُتِل علي على يد رجل من فريق جهر بالمعارضة وجهر بالحرب ولم يمنعه هذا أن يصل إليه.
إنه انحياز لحرية الناس وحقوقهم على حساب أمن السلطة! وهو انحياز فلسفي كبير يترتب عليه معظم النظام السياسي والأمني في الدولة الإسلامية، وهو انحياز لاقتراب الحكام من العامة.
لهذا فمن أغرب الغريب أن يُعايَر النموذج الإسلامي بأن ثلاثة من خلفائه الأربعة قُتِلوا! وأن يصدر هذا ممن عاش في زمن تهلك فيه الأمم والجماعات والفصائل بدعوى حماية النظام والحفاظ على الأمن القومي ويُشنق فيه الناس بتهم تكدير السلم العام!! أو لعل هذا هو الطبيعي، فإن من نشأ في ظل هذا النظام لم يعرف معنى الحرية فهو أخوف على أمنه منه على حريته وكرامته!
إن أمرا يغفل عنه الأكثرون من العلمانيين الذين يتحدثون في الشأن السياسي الإسلامي، بل ويفهمونه بالمقلوب، ذلك هو احتواء الإسلام على نصوص "السمع والطاعة" للحاكم، ذلك أنهم يغفلون عن أن بنية النظام السياسي الإسلامي تجعل المجتمع قويا متماسكا قادرا على مواجهة السلطة، لذلك كان لا بد من وجود قيمة السمع والطاعة (إلا في حدود) لكي تظل الدولة ونظامها ممسوكا بالقيم الإسلامية الحاكمة على الحاكم والمحكوم معا. في حين يخلو السياق العلماني من معنى السمع والطاعة لأن الشعوب في حقيقة الأمر أسرى لدى الدولة التي تحتكر القوة وتملك فرض النظام وإخضاع الناس له، ولذلك يبرز في النظام العلماني معنى محاسبة السلطة ومراقبتها لمنعها من التغول، في حين ينحو النظام الإسلامي إلى حراسة المجتمع القوي المتكتل من التفلتهذا الانحياز إلى الإنسان وكرامته له وجه آخر، لأنه انحياز ضد القصور والزخارف والزينة، فالحضارة الإسلامية تهتم لأن تقيم مجتمعا تسوده الكرامة والعدل والإنصاف ولو كان يسكن بيوت الحجر والشعر والطين، وتنبذ وتحارب مجتمعا تسوده ناطحات السحاب وتغمره وسائل الترفيه والترف بينما إنسانه مذلول أو مطحون أو مسحوق ماديا أو نفسيا! وهذا افتراق خطير!
إن مجتمعات المادة قد تنبهر لروائع قصور الحمراء وتاج محل وفنون المآذن والقباب المملوكية بينما الحكم الأخلاقي للحضارة الإسلامية على هذه العصور سلبي، نعم قد نستدل بكل هذا على تقدم العلوم والفنون في الجانب العلمي من الحضارة الإسلامية، لكن يظل العصر الراشدي الذي خلا من كل هذا هو العصر الذي تتشوق له النفوس أكثر من عصور مماليك الشرق أو مغول الهند أو بني الأحمر الأندلسيين!
لكل ما سبق ولغيره مما لا تتسع له سوى الكتب ذات المجلدات.. كان وجود النموذج السياسي الإسلامي الكامل –ولو لثلاثين سنة- نعمة عظيمة على الأمة، وتفردا تاما من تفرداتها وتميزاتها!
نشر في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية
ماريا لويزا برنيري، المدينة الفاضلة عبر التاريخ، سلسلة عالم المعرفة 225 (الكويت: المجلس الوطنيّ للثّقافة والفنون والآداب، سبتمبر 1997)، ص15، 16. نفسه، ص19. راجع هذه المقالات: طبيعة السلطة في الإسلام كيف نظم الإسلام العلاقة بين السلطة والأمة مقاومة المجتمع الإسلامي للاستبداد (الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث) اقتباس أوروبا من المسلمين: قوة المجتمع
ومن ضمن التعليقات التي وصلتنا على المقال تعليق يتساءل عن الفائدة من وجود نموذج أصلا، خصوصا إذا كان هذا النموذج لم يطبق سوى ثلاثين عاما في تاريخ جاوز الأربعة عشر قرنا؟!
سأستعين في الإجابة على هذا السؤال بالدراسة المتميزة الموسعة التي أعدتها الباحثة الإيطالية ماريا لويزا برنيري حول "المدينة الفاضلة عبر التاريخ"، وفيه تتبعت أفكار الفلاسفة وتصوراتهم عن المدينة الفاضلة، منذ العصر القديم مرورا بعصر النهضة والتنوير والعصر الحديث.
(1) وجودٌ في مقابل العدم
كان أول ما خلصت إليه دراسة برنيري أنه ليس ثمة نموذج من تصورات المدينة الفاضلة قد تحقق في واقع الأرض، سواء في ذلك من تصوروا وامتلكوا سلطة التنفيذ أو من تصوروا وامتلكوا سلطة النداء والتوجيه أو من تصوروا الأمر في خيالهم فحسب.
وكثيرا ما راود الخيال الغربي فكرة نهاية التاريخ وأنهم بصدد الوصول إلى اللحظة التي يكتشف فيها البشر الطريق الأمثل لنظام حياتهم، بل هي الفكرة الجوهرية في المسيرة العلمانية (ويراجع في هذا كتابات د. عبد الوهاب المسيري) بل أعلن بعضهم في لحظات بعينها أنهم الآن عند نهاية التاريخ كما فعل فرانسيس فوكوياما عند انتصار الليبرالية وانهيار الاتحاد السوفيتي، ثم ما يلبث أن يسفر الزمن عن أن التاريخ لم ينتهِ بعد!
والفلسفة الغربية أشبه بالغابة الضخمة المشتبكة المتناقضة من الأفكار والتصورات والرؤى، وما نراه نحن في العالم العربي –لضعف الثقافة وقلة الاطلاع- ثوابت عندهم هي في الحقيقة موضوعات تهتز بشدة وتعاني من انتقادات جذرية وكاسحة، بل إن الفلسفة الغربية أنتجت مصطلح "ما بعد كذا" لتعبر عن "انتهاء" مرحلة أو فلسفة دون استيضاح ماذا سيليه.
فالخلاصة أن "وجود نموذج" يمثل القدوة في الفكر الإسلامي هو بحد ذاته إنقاذ من التيه والضياع الفلسفي الكبير الذي يؤدي إليه "عدم وجود" نموذج في الماضي، وكذلك عدم اليقين بنموذج واضح الملامح سيأتي به المستقبل.ولا يجد المرء تشبيها لهذا الوضع خيرا من قول الله تعالى {اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ} [البقرة: 257].
(2) الواقعية في مقابل النظرية
في بداية بحثها، تعترف برنيري بأن "عصرنا هو عصر التسويات والحلول الوسطى، والسعي لجعل العالم أقل شرورا. والحالمون من أصحاب الرؤى أصبحوا موضع السخرية أو الاحتقار، والناس "العمليون" هم الذين يحكمون حياتنا"، ومنذ القرن التاسع عشر بدأ انحلال "التفكير اليوتوبي" وأصيب بعدوى "الواقعية"هكذا إذن، لم تستطع تصورات المدينة الفاضلة أن ترفع من مستوى الحياة الواقعية، بل كان تأثير الواقع أشد فأنزل المثاليات النظرية من عليائها لتنتج تصورات أخرى للمدينة الفاضلة أقل حلما ومثالية.
وكانت واحدة من إشكاليات الموضوع أنهم بدلا من محاولة "اكتشاف قوانين الطبيعية، فضَّلوا أن يخترعوها أو يعثروا عليها في "سجلات الحكمة القديمة"... وبدلا من أن يقيموا يوتوبياتهم على تجمعات حية وبشر مثل أولئك الذين يعرفونهم، أقاموها على تصورات مجردة"هنا تبدو قيمة نموذج عملي واقعي تحقق في التاريخ لثلاثين سنة أمرا عظيما، فهو نموذج لم يحلق في آفاق الخيال ولم يحاول اختراع قوانين الطبيعة، بل نجح في التعامل مع واقع البشر. ولقد استمر ذلك النموذج ثلاثين سنة في قمته ثم بدأ النزول عن هذه القمة تدريجيا وببطء، لكن الأمة التي خرجت في هذه الثلاثين سنة هي الأمة التي ظلت ألف سنة تشع علما وحضارة.
فالخلاصة أن تحقق النموذج في واقع الحياة لعدد من السنين يمثل في حد ذاته القدرة على إعادة تحققه مرة أخرى، فيصير السعي إليه سعيا واقعيا، وهو خير من السعي وراء سراب تصورات حالمة لم تتحقق ولم تستطع أن تخرج من سطور الكتب إلى التعامل مع واقع الناس.
(3) الوضوح في مقابل التناقضات
إذا صار لدينا نموذج عملي متحقق في واقع الناس، أثمر ذلك نجاة من الاشتباكات والتناقضات في تحديد النموذج المعرفي والكليَّات الكبرى، فلن تصير الأمة ضحايا للأفكار التي تمثل ردات فعل على واقعها بالمقام الأول، إذ لن تضطر لدخول صراعات دموية للخروج من عصر الإقطاع إلى عصر الشيوعية أو من عصر الشيوعية إلى عصر الليبرالية أو من عصر الكنيسة إلى عصر الدولة.. وهكذا!
إن وجود النموذج العملي هو ما يحدد أمورا كثيرة هي من كُليَّات وأصول النظام المعرفي، مثل المرجعية النهائية وتفاعلها مع الوقائع التفصيلية المستجدة، ومثل الانحياز بين الفردية والجماعية، بين المادية والروحية، وما ينبثق عن كل هذا من أنظمة وأنماط اقتصادية واجتماعية وغيرها.
ثم إن طول فترة النموذج –وهو في حالته المثالية- لتبلغ ثلاثين سنة يسمح بوجود الكثير من الأحداث والتقلبات التي تسفر في النهاية عن وجود نموذج ثري.
وإن أول وأهم ما في هذا النموذج الراشدي هو أنه نموذج لبشر يحكمون بشرا، ليسوا آلهة ولا رسولا ولا كهنة يتصل أحدهم بالسماء، وهو ما يجعلها تجربة بشرية خالصة في التطبيق وإن كانت مرجعيتها سماوية ربانية، لكن الحاكم والمحكوم وكافة المتأثرين بالنظام يعرفون أنهم محكومون بنظام يجتهد فيه البشر للبشر.
ولقد شهدت هذه الثلاثون عاما التقلبات التي تمر بالدول كلها، بدءا من مخاضات التأسيس (في عهد أبي بكر) ثم مرحلة التوسع والنمو والنضج (في عهد عمر) ثم الرخاء والازدهار (عهد عثمان) ثم الفتن الداخلية (أواخر عهد عثمان إلى عهد الحسن بن علي)، مع ما شهده كل هذا من تعديلات في بنية النظام وانتقال للسلطة وتأسيس للمؤسسات وسياسة للأموال وتعامل مع المعارضة السلمية والمسلحة... وغير ذلك!
وكل هذه الأمور وغيرها تختلف العقول بشأنها إن غاب النص وغاب النموذج التطبيقي له، وإن الأمة التي تسعى لاستعادة نموذج سبق وتعامل مع الأوضاع السياسية لهي أكثر بصيرة وأوضح طريقا من أمة تبحث عن نموذج لم تر ملامحه ولا تحسم كثيرا من أسئلته الجوهرية.
(4) روح الحضارة الإسلامية
ونختم المقال بضرب المثال:
إن المسلمين يؤمنون بأن عصر الخلافة الراشدة هو القدوة التي يتمثلونها، ولهذا آثار ضخمة على مستوى التصور وعلى مستوى التطبيق، وقد ضربنا في المقال السابق مثلا بالحاكم المسلم الذي يظل عبر التاريخ يُحاكم إلى نماذج الخلفاء الراشدين باعتبارهم المثال الذي ينبغي تجديده، ولقد يكون الحاكم المسلم أنجز –بالمعيار الدنيوي- إنجازا عظيما لكن جمهرة الفقهاء والمؤرخين لا يرضون عنه، وهو هو نفسه الذي لو كان في سياق غربي لكان بغير شك من عظماء مؤسسي الدول، وذلك لأن وجود نموذج في النظام الإسلامي يمثل الحق الذي يعلو على القوة، وانعدام هذا النموذج في السياق العلماني يؤدي لأن تكون القوة هي معيار الحق.
الآن نضرب مثالا آخر لآثار الإيمان بنموذج الخلافة الراشدة، هو أن روح الحضارة الإسلامية تنحاز إلى الإنسان لا إلى البنيان، وإلى المعنى أكثر من المادة.
لقد انتهى عصر الخلافة الراشدة، الذي هو العصر الذهبي في الذهن الإسلامي، ولم يكن للمسلمين قصور مشيدة ولا بيوت فاخرة ولا مباني ضخمة ولا مساجد مزخرفة ولا ثياب مزينة.. لقد أتى هذا كله فيما بعد، في العصور التي لا تمثل قدوة. إلا أن هذا العصر كان هو عصر الإنسان، العصر الذي يأمن فيه الإنسان على نفسه وعرضه وأهله، لا يستطيع حاكم أن يستذله أو يقهره أو يخيفه أو يظلمه، عصر تستطيع فيه المعارضة أن تواجه الخليفة قولا وصراخا وبالسلاح أحيانا ثم يكون لهم بعد هذا حقوق لا ينتقص منها.
إن الذي ينتقص من عصر الخلافة لأن ثلاثة من خلفائه قُتِلوا ينسى أن الذين قُتلوا لم يُقتلوا لظلم وقع منهم وإنما لاتساع هامش المساحة الممنوحة للجميع، لقد استطاع العبد الفارسي أن يهدد عمرا قبل أن يقتله ويحيا في المدينة لا يمسه سوء، ثم استطاع هذا العبد أن يصلي في الصف الأول خلف عمر وأن يطعنه، وحاصر المتمردون بيت عثمان وهو من حماهم ومنع أصحابه من مقاتلتهم والتصدي لهم بعد مجهود وافر في بيان ما هم عليه من الباطل والدفاع عن نفسه، وكان من قبل ذلك قد تعرض لمحاولة اغتيال فلم يعاقب أصحابها باعتبار أن الجريمة لم تقع فلا يستحقون عقابا، وقُتِل علي على يد رجل من فريق جهر بالمعارضة وجهر بالحرب ولم يمنعه هذا أن يصل إليه.
إنه انحياز لحرية الناس وحقوقهم على حساب أمن السلطة! وهو انحياز فلسفي كبير يترتب عليه معظم النظام السياسي والأمني في الدولة الإسلامية، وهو انحياز لاقتراب الحكام من العامة.
لهذا فمن أغرب الغريب أن يُعايَر النموذج الإسلامي بأن ثلاثة من خلفائه الأربعة قُتِلوا! وأن يصدر هذا ممن عاش في زمن تهلك فيه الأمم والجماعات والفصائل بدعوى حماية النظام والحفاظ على الأمن القومي ويُشنق فيه الناس بتهم تكدير السلم العام!! أو لعل هذا هو الطبيعي، فإن من نشأ في ظل هذا النظام لم يعرف معنى الحرية فهو أخوف على أمنه منه على حريته وكرامته!
إن أمرا يغفل عنه الأكثرون من العلمانيين الذين يتحدثون في الشأن السياسي الإسلامي، بل ويفهمونه بالمقلوب، ذلك هو احتواء الإسلام على نصوص "السمع والطاعة" للحاكم، ذلك أنهم يغفلون عن أن بنية النظام السياسي الإسلامي تجعل المجتمع قويا متماسكا قادرا على مواجهة السلطة، لذلك كان لا بد من وجود قيمة السمع والطاعة (إلا في حدود) لكي تظل الدولة ونظامها ممسوكا بالقيم الإسلامية الحاكمة على الحاكم والمحكوم معا. في حين يخلو السياق العلماني من معنى السمع والطاعة لأن الشعوب في حقيقة الأمر أسرى لدى الدولة التي تحتكر القوة وتملك فرض النظام وإخضاع الناس له، ولذلك يبرز في النظام العلماني معنى محاسبة السلطة ومراقبتها لمنعها من التغول، في حين ينحو النظام الإسلامي إلى حراسة المجتمع القوي المتكتل من التفلتهذا الانحياز إلى الإنسان وكرامته له وجه آخر، لأنه انحياز ضد القصور والزخارف والزينة، فالحضارة الإسلامية تهتم لأن تقيم مجتمعا تسوده الكرامة والعدل والإنصاف ولو كان يسكن بيوت الحجر والشعر والطين، وتنبذ وتحارب مجتمعا تسوده ناطحات السحاب وتغمره وسائل الترفيه والترف بينما إنسانه مذلول أو مطحون أو مسحوق ماديا أو نفسيا! وهذا افتراق خطير!
إن مجتمعات المادة قد تنبهر لروائع قصور الحمراء وتاج محل وفنون المآذن والقباب المملوكية بينما الحكم الأخلاقي للحضارة الإسلامية على هذه العصور سلبي، نعم قد نستدل بكل هذا على تقدم العلوم والفنون في الجانب العلمي من الحضارة الإسلامية، لكن يظل العصر الراشدي الذي خلا من كل هذا هو العصر الذي تتشوق له النفوس أكثر من عصور مماليك الشرق أو مغول الهند أو بني الأحمر الأندلسيين!
لكل ما سبق ولغيره مما لا تتسع له سوى الكتب ذات المجلدات.. كان وجود النموذج السياسي الإسلامي الكامل –ولو لثلاثين سنة- نعمة عظيمة على الأمة، وتفردا تاما من تفرداتها وتميزاتها!
نشر في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية
ماريا لويزا برنيري، المدينة الفاضلة عبر التاريخ، سلسلة عالم المعرفة 225 (الكويت: المجلس الوطنيّ للثّقافة والفنون والآداب، سبتمبر 1997)، ص15، 16. نفسه، ص19. راجع هذه المقالات: طبيعة السلطة في الإسلام كيف نظم الإسلام العلاقة بين السلطة والأمة مقاومة المجتمع الإسلامي للاستبداد (الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث) اقتباس أوروبا من المسلمين: قوة المجتمع
Published on April 04, 2016 12:59
March 31, 2016
دروس من تجربة شيخ المجاهدين
"ونحن نرقب ذلك اليوم الذي يتحول فيه الحجر بأيدي حماس إلى رصاص، ويتبدل الحجر، وتحل القنبلة والبندقية".عبد الله عزام – قبل استشهاده بستة أشهر
(1) شيخان
شيخان من فلسطين، ومن حركة الإخوان المسلمين، كان لهما نصيب الأسد من حركة الجهاد الإسلامي في النصف الثاني من القرن العشرين: عبد الله عزام، وأحمد ياسين!
وعزام أصغر من ياسين بأربع سنوات، لكن سبقه إلى الشهادة بخمسة عشر عاما، وكان عزام يلقب قرينه أحمد ياسين بـ "رمز صمود الحركة الإسلامية"ومن المؤسف أن تراث الشيخين لا يُعامل بالاحترام ولا بالاهتمام اللائق به من شباب المسلمين، وفي القلب منهم شباب الحركات الإسلامية الذين يفورون بالغضب والطاقة، ولئن كان البعض يتهيب الإقدام على الإرث الكبير لعزام، فما هو عذر من يتخلف عن الاهتمام بالحلقات الثمانية الوحيدة التي تمثل خلاصة فكر وتجربة الشيخ أحمد ياسين؟! (وأعني بها: حلقات شاهد على العصر).
والشيخان امتداد أصيل لحسن البنا وسيد قطب، وكلاهما يعترف لكليهما بالفضل والأثر في نفسه وفكره، ولقد كتب عزام كتابا عن قطب سمَّاه "عملاق الفكر الإسلامي"، وكان ياسين يجتهد في شبابه لإدخال وتدريس الظلال إلى قطاع غزة بطباعته ونشره، ومن المثير للأحزان الآن القول: بأن نجاح الشيخين في عملهما هو بمقدار ما فارقا فيه النهج الذي صارت إليه الجماعة الأم في مصر، وهو ما سنرى بعضه بعد قليل، وربما نتعرض لبعضه الآخر في مقالات لاحقة.
وكنا قد وعدنا في المقال الماضي أن نستكمل بعض الدروس من سيرة وخلاصة تجربة الشيخ أحمد ياسين، فالله المستعان.
(2) مرحلة الاستضعاف
لم يقبل الشيخ ياسين أن تكون الحركة الإسلامية في أي وقت من الأوقات تحت تحكم السلطة العميلة أو حتى "رفاق الكفاح" (!!) العلمانيين، لو صحَّ التعبير، صحيحٌ أنه سعى ما وسعه الجهد ألا يثور اقتتال داخلي بين حماس وبين فتح أو سلطة فتح فيما بعد، إلا أنه في الوقت نفسه لم يُرق كرامته وكرامة الحركة الإسلامية سعيا لهذا التوافق ولم يجعل يده الأدنى والأسفل ليشتري سلاما مع فتح ومع السلطة.
لقد دخل الشيخ ياسين مواجهات بعضها دموي مع فتح منذ الثمانينات، وبدأ هذا حين أرادوا وضع شيوعيين ومسيحيين في مجلس أمناء الجامعة الإسلامية (فرع الأزهر بغزة) فوقف الإسلاميون ضد هذه المحاولة وأفشلوها، وكانت جهودهم تلك تصب في صالح محمد عواد العميد القديم للجامعة رغم أنه لم يكن صالحا بل لا يحب نصرة الإسلام كما يصفه الشيخ ياسين، لكن الحفاظ على إسلامية الجامعة كان هو الهدف الأول والأكبر، وهو ما تمّ، وكان هذا في عام (1980م).
بعد ذلك بعامين كانت الحركة الإسلامية تخوض مواجهة أخرى ليكون رئيس الجامعة إسلاميا فيحفظ لها هويتها ومظهرها الإسلامي ورشحوا لها د. محمد صقر المشهود له بالعلم بدلا من رياض الأغا العلماني ذي الفساد المالي والاتصالات مع اليهود والذي تتكرر منه الشكوى، وتمسكت الحركة الإسلامية بمرشحها ووصل الأمر إلى صدام دموي بين الشباب في الجامعات واغتالت فتح واحدا من الأساتذة الإسلاميين، وفي النهاية فرضت الحركة الإسلامية رأيها وفشلت بلطجة فتح في انتزاع الجامعة وتلقى شبابها ما يستحقون، وخرجت الحركة الإسلامية منتصرة في هذه المعركة، وانتهى زمن إجبارها علنا على شيء لا تريده لتبدأ بعدئذ مرحلة التفاهم.
لكن مرحلة التفاهم "العلني" يصحبها كذلك محاولات اغتيال وتصفية سرية، فقد حدث أن أدخلت فتح قناصا تابعا لها إلى قطاع غزة لاغتيال بعض عملاء إسرائيل، فدسَّت في قائمة العملاء أسماء تابعة للحركة الإسلامية، فلما اكتشف الشيخ ياسين هذا حذرهم وهددهم "أوعى، والله بتحرقوا البلد أنتم"! فكفُّوا وانتهى الأمر.
ثم انتقل الأمر لنزاعات الشباب، وتجرأوا ذات يوم على جرح فتاة في وجهها وإلقاء "ماء نار" على شاب فأصيب بالعمى، فكان الرد جاهزا، يقول الشيخ: "فمش معقول نتحمل أن واحد يفقد عينيه وهم بيتفرجوا عليه، وست طالبة في الجامعة يروحوا يضربوا بالشكل هذا، كلام مش منطقي.. ناخد قرار بضرب عناصر معينة منهم اللي إلها يد في هذا، فهم قاموا بالرد وضربوا عناصر منا.... بس الأغلبية كانت منهم، يعني الضرب منا واحد بس، هم انضربوا كذا واحد، واتكسروا وانتهت بعد هيك بمصالحة يعني ضمنية، تهدئة داخلية بدون صراعات تانية".
والملاحظ في هذه الوقائع جميعا أن الحركة الإسلامية كانت في بداياتها الأولى، أي أنها في "مراحل الاستضعاف" بالتعبير المشهور، لكنها مع ذلك لم تستلذ البقاء في هذه المرحلة ولم تسكت عن كل حق نزولا عند "سمات المرحلة"، وإنما كان الاستضعاف هو التحدي الذي تحاول دائما مغالبته والتخلص منه والتحول عنه.
وقد تطور الأمر إلى ما هو أكثر من ذلك فيما بعد، وذلك أن حركة فتح منذ أن صار لها سلطة عملت على القضاء على الحركة الإسلامية والانفراد تماما بالساحة، وجرت في هذا الصدد مواجهات أخرى، لكن الشيخ ياسين كان حاسما في عدم السماح بالقضاء على الحركة الإسلامية، وآل الأمر إلى إغلاقات شكلية للمكاتب لكن الأنشطة تظل كما هي.
(3) حدود المواجهة
في المقابل ينبغي أن نذكر كذلك أن هذه المواجهات هي مواجهات محسوبة لا مفتوحة، ومنضبطة لا مندفعة، وهي بغرض الردع لا بغرض إشعال حرب، وهو من فقه المرحلة كذلك، فمثلما ابتلينا بمن استلذ بمرحلة الاستضعاف ابتلينا كذلك بمن يريد القفز من مرحلة الولادة إلى مرحلة التمكين، أو كما يقول أحد إخواننا العقلاء: نحن بين منهج "سلميتنا أقوى من الرصاص" ومنهج "بندقيتنا أقوى من الصواريخ والطائرات والبوارج"!!
إن الشيخ الذي أعد شبابه لمثل هذه المواجهات هو نفسه من منعهم من محاربة السلطة الفلسطينية حتى بعد توقيعها اتفاقية أوسلو لئلا يؤدي هذا إلى حرب داخلية، لا سيما إن كانوا لا يستطيعون حسمها لصالحهم، وهو نفسه الذي عاقب بعض شبابه لأنه في غمرة الحماس هاجم مبنى الهلال الأحمر (وكان حينئذ قلعة الشيوعيين) ودمَّر خمارة وكازينو، وأخبرهم أنهم بهذا أشبه بالعملاء الذين ينفذون رغبة الإسرائيليين بإشعال اقتتال داخلي، بل ويضعون أنفسهم أداة لفتح (التي استثارتهم) في حربها مع الجبهة الشعبية (اليسارية الشيوعية)، وهي معركة يجب ألا تحشر الحركة الإسلامية نفسها فيها، كذلك أخبرهم أن الخمارة والكازينو وغيرهما إنما هو "عدو مؤجل" بينما ينبغي الالتفات لأصل المرض وهو الذي سمح بوجود هذه الخمارات والكازينوهات من الأساس.
وهو نفسه الذي أصرَّ ألا يكون ثمة اقتتال بين فصائل الشعب الفلسطيني ما وسعه ذلك، وقبل أن تناور السلطة سياسيا بالإغلاق الشكلي للمكاتب الإدارية التي تمثل واجهة نشاط الحركة الإسلامية، مع بقاء الأنشطة كما هي.لكن أمرا هنا ينبغي الالتفات له، وهو حرص الشيخ على الاستفادة حتى من أخطاء شبابه، فأولئك الذين تحمسوا وهاجموا مبنى الهلال الأحمر (قلعة الجبهة الشعبية) ودمروا خمارة وكازينو، أثاروا على الحركة الإسلامية هياجا إعلاميا واتهامات بالعنف والإرهاب ... إلى آخر هذه الترهات، وطُلِب منه أن يصدر بيان استنكار فرفض، وقال: لسنا متهمين حتى نصدر بيانات، فليثبتوا هم أولا أننا نحن من فعلنا. ثم كان تقييمه للحدث (رغم رفضه له) أن له وجها إيجابيا وهو "إظهار قوة الحركة الإسلامية على الساحة".
وهذا درس ينبغي أن يستفيد منه من يعاني من إسهال الاستنكار والإدانة حتى لو لم يكن له أي علاقة بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد!!
(4) دروس في بناء التنظيم
كان الشيخ ينفصل عمليا عن تنظيم الإخوان القديم في فلسطين، وكان يعرف أنه يبدأ طورا جديدا من الحركة الإسلامية، أو بتعبيره هو "أنا لا يعنيني الأسماء، أنا يعنيني الجوهر، ويهمني الجوهر، أنا الآن بدي أبدأ طور جديد من الحركة الإسلامية في المواجهة والمقاومة، فسأعطي هذا الطور من الحركة الإسلامية اسماً جديداً يتمشى مع الواقع، والواقع يحتاج أن يكون هنا مقاومة، ولذلك لابد أن تسمى الحركة بحركة المقاومة الإسلامية".
ومن كان هذا شأنه لا بد أن يؤسس عمله على:
أ. صبر مديد: لا يسع من بدأ في عمل جماعي إلا أن يبذل الكثير والكثير والكثير من المجهود والعنت، مع الصبر والمشقة، وهذا الشيخ القعيد النحيف الضعيف يحكي أنه بدأ العمل بعشرة أفراد فقط، لكنهم بعد وقت صاروا اثنين أو ثلاثة فحسب!! فلم يصبه هذا بيأس أو بتردد وإنما تابع العمل وواصل البناء.
وظل الشيخ ياسين ينتظر ثلاثة عشر عاما حتى تحول عمله إلى تيار، إذ بدأ عمل الأسر منذ سنة 1967، واستمر بلا انقطاع حتى تحول إلى تيار بعد 1980.
ب. مغالبة الأقدار بعضها ببعض: وهي سنة كونية، ولا نحتاج أن نذكرها إلا لأن بعض الشباب في غمرة الحماس يظن أنه سيبدأ المواجهة الآن مع "النظام العالمي" كله، ويظن أنه قادر على اختراق كل الحدود والقيود لمجرد عدم اعترافه بها.. وهو أمر لم تفعله حركة مقاومة من قبل، بل كل حركة تبدأ من واقع هي خاضعة فيه لظروف لا تملك منها فكاكا، فتظل تعمل تحت السقوف القائمة وبالحدود المتاحة وبالقوانين المفروضة عليها، وهي في كل هذا تتحين الفرصة لتعديل وضعها وتقوية نفسها حتى تصل إلى خرق هذه السقوف والحدود والقوانين.
هذا الشيخ أحمد ياسين بدأ العمل في نشاطه الإسلامي "المعلن" بتصاريح من الإسرائيليين، وأسسوا الجمعية الإسلامية بتصاريح من الداخلية الإسرائيلية، وتحالف في بعض الأحيان مع فتح ضد اليسار كما في انتخابات الهلال الأحمر، وكان يلتقي ويتفاوض مع مسؤولين من فتح، وقَبِل بكثير من الأوضاع التي فرضتها السلطة الفلسطينية ومن قبلها الإسرائيلية مما لم يمكنه دفعه، أو كان دفعه يترتب عليه ضرر أشد. وكل هذه أمور يحتاج الشباب المسلم العامل أن يعيها ويفقهها كي لا يكون وقودا لشعارات وعبارات خيالية تحرق الجهود في معارك عبثية وعدمية.
جـ. الشورى الحقيقية والمؤسسية: كان الشيخ ياسين مؤسس التنظيم لكنه لم يكن التنظيم كله، بل إنه في لحظة ما عرف أن التحقيقات الإسرائيلية ستقود إليه فترك التنظيم تماما ليتولاه غيره، فلما اعتقلوه فعلا (1984م) لم يتوقف التنظيم ولم يتأثر بغيابه، ثم لما خرج من الاعتقال أخذ إجازة سنة من التنظيم لئلا يتتبع اليهود أمر التنظيم، ثم لما عاد إلى التنظيم عاد جنديا لا في القيادة.
وكثير من مراحل المواجهة مع فتح أو السعي للتسلح أو غيره تم والشيخ ياسين في السجن أو خارج التنظيم. ولما اندلعت الانتفاضة كرر هذا الأسلوب، يقول: "اعتقلوا قبلي، واعترفوا عليَّ كمؤسس، واللي بدأ الانتفاضة، والسلطة (الإسرائيلية) من هنا وجدت أنه مش في مصلحتها تعتقلني، فسابتني في الخارج لكي تصطاده من حولي، وتعرف الأمور، أنا في تلك الفترة اعتزلت كل العمل، وتركت العمل لآخرين يشتغلوا في عمل الانتفاضة والخطة وكله كل شيء".
د. الانضباط والاتزان: اعتمد الشيخ ياسين نهج رصد وتصفية عملاء الاحتلال قبل نهج العمليات ضد الاحتلال نفسه، فأول عمليات الجهاز العسكري كانت محاولات كشف شبكات العملاء التابعين للإسرائيليين، وكانوا يقصدون القبض عليه والتحقيق معه لكشف شبكة العمالة، وكان التحقيق مع العميل يصوَّر ثم تعرض اعترافاته على لجنة تقوم بعملية التحليل والمحاكمة في نفس الوقت، قبل أن تصدر حكمها عليه، ولم يكونوا يقدمون على ذلك قبل الاشتباه الأكيد في أمره، واستطاعوا كشف العديد من الشبكات ومن أساليب الإسقاط. ومع ذلك، فهم لما قتلوا مشتبها به بالعمالة قبل أن يثبت عليه هذا بشكل قاطع دفعوا الدية لأهله.
ه. السرية: اعتمد الشيخ كذلك نهج السرية، فلم يكن يعلن لا عن تصفية عملاء، ولا في المرحلة التالية عن العمليات التي قاموا بها ضد الاحتلال أو المستوطنات، يقول: "ولم تكن بيانات، كنت أحب العمل وأُبْقي العدو تائها".
(5) درس في طبائع الشعوب
من بين كل كلام الشيخ علق بذهني هذه العبارات التي تمثل بحد ذاتها درسا في طبائع الشعوب التي يجب أن يفققها العاملون للإسلام، يفقهونها ليعملوا على بصيرة لا لينشغل بعضهم بشتم هذه الشعوب، يذكر الشيخ وهو يصف صعوبة البدايات أن الناس كانت تحب عبد الناصر وتكره الإخوان المسلمين في ذلك الوقت، حتى أنهم هتفوا لما مات "الله حي وناصر حي"، وذلك لأن "الدعاية المصرية في غرس المقاومة العربية في ذلك الوقت فظيعة جداً .. فظيعة جداً، لا تتصورها قد إيش"، و"كان الناس في ذهول عند موته" حتى إن بعض الخطباء لما خطب ضد عبد الناصر هاجمه الناس، ويحكي الشيخ عن رجل كبير جاءه بعد الخطبة واستنكر عليه عدم ثنائه وترحمه على عبد الناصر، وقال له: ماذا تريد من عبد الناصر؟ يطبق الإسلام أم يحارب إسرائيل، فقال الشيخ ياسين: "الاثنين واحد، إذا لم يأخذ الإسلام سلاحه معناه إنه مهزوم، ولذلك هو لم يؤدي الأمانة اللي ربنا استأمنه عليها".
ويضيف الشيخ أن الدعاية والإعلام يجعل الناس مخدرين، ويضرب مثلا على ذلك بحال الشعب المصري بعد هزيمة يونيو 1967، "كان الشعب المصري اللي طلع يهتف لعبد الناصر بعدما استقال .. طيب ما هو الثاني مخدر خالص، طيب.. واحد حقق هزيمة، وقال: أنا بأتحمل الهزيمة، وبيتحملها وبيرجع يمسك المسؤولية تاني، وبيهتفوله فمعناها برضه إن الشعب مخدر خالص، مافيش في العالم واحد بيتحمل هزيمة وبيرجع على الكرسي تاني، لكن هذا الواقع هو اللي صار في بلدنا".
نشر في ساسة بوست
حماس الجذور والميثاق، ضمن "الذخائر العظام" 1/852.
(1) شيخان
شيخان من فلسطين، ومن حركة الإخوان المسلمين، كان لهما نصيب الأسد من حركة الجهاد الإسلامي في النصف الثاني من القرن العشرين: عبد الله عزام، وأحمد ياسين!
وعزام أصغر من ياسين بأربع سنوات، لكن سبقه إلى الشهادة بخمسة عشر عاما، وكان عزام يلقب قرينه أحمد ياسين بـ "رمز صمود الحركة الإسلامية"ومن المؤسف أن تراث الشيخين لا يُعامل بالاحترام ولا بالاهتمام اللائق به من شباب المسلمين، وفي القلب منهم شباب الحركات الإسلامية الذين يفورون بالغضب والطاقة، ولئن كان البعض يتهيب الإقدام على الإرث الكبير لعزام، فما هو عذر من يتخلف عن الاهتمام بالحلقات الثمانية الوحيدة التي تمثل خلاصة فكر وتجربة الشيخ أحمد ياسين؟! (وأعني بها: حلقات شاهد على العصر).
والشيخان امتداد أصيل لحسن البنا وسيد قطب، وكلاهما يعترف لكليهما بالفضل والأثر في نفسه وفكره، ولقد كتب عزام كتابا عن قطب سمَّاه "عملاق الفكر الإسلامي"، وكان ياسين يجتهد في شبابه لإدخال وتدريس الظلال إلى قطاع غزة بطباعته ونشره، ومن المثير للأحزان الآن القول: بأن نجاح الشيخين في عملهما هو بمقدار ما فارقا فيه النهج الذي صارت إليه الجماعة الأم في مصر، وهو ما سنرى بعضه بعد قليل، وربما نتعرض لبعضه الآخر في مقالات لاحقة.
وكنا قد وعدنا في المقال الماضي أن نستكمل بعض الدروس من سيرة وخلاصة تجربة الشيخ أحمد ياسين، فالله المستعان.
(2) مرحلة الاستضعاف
لم يقبل الشيخ ياسين أن تكون الحركة الإسلامية في أي وقت من الأوقات تحت تحكم السلطة العميلة أو حتى "رفاق الكفاح" (!!) العلمانيين، لو صحَّ التعبير، صحيحٌ أنه سعى ما وسعه الجهد ألا يثور اقتتال داخلي بين حماس وبين فتح أو سلطة فتح فيما بعد، إلا أنه في الوقت نفسه لم يُرق كرامته وكرامة الحركة الإسلامية سعيا لهذا التوافق ولم يجعل يده الأدنى والأسفل ليشتري سلاما مع فتح ومع السلطة.
لقد دخل الشيخ ياسين مواجهات بعضها دموي مع فتح منذ الثمانينات، وبدأ هذا حين أرادوا وضع شيوعيين ومسيحيين في مجلس أمناء الجامعة الإسلامية (فرع الأزهر بغزة) فوقف الإسلاميون ضد هذه المحاولة وأفشلوها، وكانت جهودهم تلك تصب في صالح محمد عواد العميد القديم للجامعة رغم أنه لم يكن صالحا بل لا يحب نصرة الإسلام كما يصفه الشيخ ياسين، لكن الحفاظ على إسلامية الجامعة كان هو الهدف الأول والأكبر، وهو ما تمّ، وكان هذا في عام (1980م).
بعد ذلك بعامين كانت الحركة الإسلامية تخوض مواجهة أخرى ليكون رئيس الجامعة إسلاميا فيحفظ لها هويتها ومظهرها الإسلامي ورشحوا لها د. محمد صقر المشهود له بالعلم بدلا من رياض الأغا العلماني ذي الفساد المالي والاتصالات مع اليهود والذي تتكرر منه الشكوى، وتمسكت الحركة الإسلامية بمرشحها ووصل الأمر إلى صدام دموي بين الشباب في الجامعات واغتالت فتح واحدا من الأساتذة الإسلاميين، وفي النهاية فرضت الحركة الإسلامية رأيها وفشلت بلطجة فتح في انتزاع الجامعة وتلقى شبابها ما يستحقون، وخرجت الحركة الإسلامية منتصرة في هذه المعركة، وانتهى زمن إجبارها علنا على شيء لا تريده لتبدأ بعدئذ مرحلة التفاهم.
لكن مرحلة التفاهم "العلني" يصحبها كذلك محاولات اغتيال وتصفية سرية، فقد حدث أن أدخلت فتح قناصا تابعا لها إلى قطاع غزة لاغتيال بعض عملاء إسرائيل، فدسَّت في قائمة العملاء أسماء تابعة للحركة الإسلامية، فلما اكتشف الشيخ ياسين هذا حذرهم وهددهم "أوعى، والله بتحرقوا البلد أنتم"! فكفُّوا وانتهى الأمر.
ثم انتقل الأمر لنزاعات الشباب، وتجرأوا ذات يوم على جرح فتاة في وجهها وإلقاء "ماء نار" على شاب فأصيب بالعمى، فكان الرد جاهزا، يقول الشيخ: "فمش معقول نتحمل أن واحد يفقد عينيه وهم بيتفرجوا عليه، وست طالبة في الجامعة يروحوا يضربوا بالشكل هذا، كلام مش منطقي.. ناخد قرار بضرب عناصر معينة منهم اللي إلها يد في هذا، فهم قاموا بالرد وضربوا عناصر منا.... بس الأغلبية كانت منهم، يعني الضرب منا واحد بس، هم انضربوا كذا واحد، واتكسروا وانتهت بعد هيك بمصالحة يعني ضمنية، تهدئة داخلية بدون صراعات تانية".
والملاحظ في هذه الوقائع جميعا أن الحركة الإسلامية كانت في بداياتها الأولى، أي أنها في "مراحل الاستضعاف" بالتعبير المشهور، لكنها مع ذلك لم تستلذ البقاء في هذه المرحلة ولم تسكت عن كل حق نزولا عند "سمات المرحلة"، وإنما كان الاستضعاف هو التحدي الذي تحاول دائما مغالبته والتخلص منه والتحول عنه.
وقد تطور الأمر إلى ما هو أكثر من ذلك فيما بعد، وذلك أن حركة فتح منذ أن صار لها سلطة عملت على القضاء على الحركة الإسلامية والانفراد تماما بالساحة، وجرت في هذا الصدد مواجهات أخرى، لكن الشيخ ياسين كان حاسما في عدم السماح بالقضاء على الحركة الإسلامية، وآل الأمر إلى إغلاقات شكلية للمكاتب لكن الأنشطة تظل كما هي.
(3) حدود المواجهة
في المقابل ينبغي أن نذكر كذلك أن هذه المواجهات هي مواجهات محسوبة لا مفتوحة، ومنضبطة لا مندفعة، وهي بغرض الردع لا بغرض إشعال حرب، وهو من فقه المرحلة كذلك، فمثلما ابتلينا بمن استلذ بمرحلة الاستضعاف ابتلينا كذلك بمن يريد القفز من مرحلة الولادة إلى مرحلة التمكين، أو كما يقول أحد إخواننا العقلاء: نحن بين منهج "سلميتنا أقوى من الرصاص" ومنهج "بندقيتنا أقوى من الصواريخ والطائرات والبوارج"!!
إن الشيخ الذي أعد شبابه لمثل هذه المواجهات هو نفسه من منعهم من محاربة السلطة الفلسطينية حتى بعد توقيعها اتفاقية أوسلو لئلا يؤدي هذا إلى حرب داخلية، لا سيما إن كانوا لا يستطيعون حسمها لصالحهم، وهو نفسه الذي عاقب بعض شبابه لأنه في غمرة الحماس هاجم مبنى الهلال الأحمر (وكان حينئذ قلعة الشيوعيين) ودمَّر خمارة وكازينو، وأخبرهم أنهم بهذا أشبه بالعملاء الذين ينفذون رغبة الإسرائيليين بإشعال اقتتال داخلي، بل ويضعون أنفسهم أداة لفتح (التي استثارتهم) في حربها مع الجبهة الشعبية (اليسارية الشيوعية)، وهي معركة يجب ألا تحشر الحركة الإسلامية نفسها فيها، كذلك أخبرهم أن الخمارة والكازينو وغيرهما إنما هو "عدو مؤجل" بينما ينبغي الالتفات لأصل المرض وهو الذي سمح بوجود هذه الخمارات والكازينوهات من الأساس.
وهو نفسه الذي أصرَّ ألا يكون ثمة اقتتال بين فصائل الشعب الفلسطيني ما وسعه ذلك، وقبل أن تناور السلطة سياسيا بالإغلاق الشكلي للمكاتب الإدارية التي تمثل واجهة نشاط الحركة الإسلامية، مع بقاء الأنشطة كما هي.لكن أمرا هنا ينبغي الالتفات له، وهو حرص الشيخ على الاستفادة حتى من أخطاء شبابه، فأولئك الذين تحمسوا وهاجموا مبنى الهلال الأحمر (قلعة الجبهة الشعبية) ودمروا خمارة وكازينو، أثاروا على الحركة الإسلامية هياجا إعلاميا واتهامات بالعنف والإرهاب ... إلى آخر هذه الترهات، وطُلِب منه أن يصدر بيان استنكار فرفض، وقال: لسنا متهمين حتى نصدر بيانات، فليثبتوا هم أولا أننا نحن من فعلنا. ثم كان تقييمه للحدث (رغم رفضه له) أن له وجها إيجابيا وهو "إظهار قوة الحركة الإسلامية على الساحة".
وهذا درس ينبغي أن يستفيد منه من يعاني من إسهال الاستنكار والإدانة حتى لو لم يكن له أي علاقة بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد!!
(4) دروس في بناء التنظيم
كان الشيخ ينفصل عمليا عن تنظيم الإخوان القديم في فلسطين، وكان يعرف أنه يبدأ طورا جديدا من الحركة الإسلامية، أو بتعبيره هو "أنا لا يعنيني الأسماء، أنا يعنيني الجوهر، ويهمني الجوهر، أنا الآن بدي أبدأ طور جديد من الحركة الإسلامية في المواجهة والمقاومة، فسأعطي هذا الطور من الحركة الإسلامية اسماً جديداً يتمشى مع الواقع، والواقع يحتاج أن يكون هنا مقاومة، ولذلك لابد أن تسمى الحركة بحركة المقاومة الإسلامية".
ومن كان هذا شأنه لا بد أن يؤسس عمله على:
أ. صبر مديد: لا يسع من بدأ في عمل جماعي إلا أن يبذل الكثير والكثير والكثير من المجهود والعنت، مع الصبر والمشقة، وهذا الشيخ القعيد النحيف الضعيف يحكي أنه بدأ العمل بعشرة أفراد فقط، لكنهم بعد وقت صاروا اثنين أو ثلاثة فحسب!! فلم يصبه هذا بيأس أو بتردد وإنما تابع العمل وواصل البناء.
وظل الشيخ ياسين ينتظر ثلاثة عشر عاما حتى تحول عمله إلى تيار، إذ بدأ عمل الأسر منذ سنة 1967، واستمر بلا انقطاع حتى تحول إلى تيار بعد 1980.
ب. مغالبة الأقدار بعضها ببعض: وهي سنة كونية، ولا نحتاج أن نذكرها إلا لأن بعض الشباب في غمرة الحماس يظن أنه سيبدأ المواجهة الآن مع "النظام العالمي" كله، ويظن أنه قادر على اختراق كل الحدود والقيود لمجرد عدم اعترافه بها.. وهو أمر لم تفعله حركة مقاومة من قبل، بل كل حركة تبدأ من واقع هي خاضعة فيه لظروف لا تملك منها فكاكا، فتظل تعمل تحت السقوف القائمة وبالحدود المتاحة وبالقوانين المفروضة عليها، وهي في كل هذا تتحين الفرصة لتعديل وضعها وتقوية نفسها حتى تصل إلى خرق هذه السقوف والحدود والقوانين.
هذا الشيخ أحمد ياسين بدأ العمل في نشاطه الإسلامي "المعلن" بتصاريح من الإسرائيليين، وأسسوا الجمعية الإسلامية بتصاريح من الداخلية الإسرائيلية، وتحالف في بعض الأحيان مع فتح ضد اليسار كما في انتخابات الهلال الأحمر، وكان يلتقي ويتفاوض مع مسؤولين من فتح، وقَبِل بكثير من الأوضاع التي فرضتها السلطة الفلسطينية ومن قبلها الإسرائيلية مما لم يمكنه دفعه، أو كان دفعه يترتب عليه ضرر أشد. وكل هذه أمور يحتاج الشباب المسلم العامل أن يعيها ويفقهها كي لا يكون وقودا لشعارات وعبارات خيالية تحرق الجهود في معارك عبثية وعدمية.
جـ. الشورى الحقيقية والمؤسسية: كان الشيخ ياسين مؤسس التنظيم لكنه لم يكن التنظيم كله، بل إنه في لحظة ما عرف أن التحقيقات الإسرائيلية ستقود إليه فترك التنظيم تماما ليتولاه غيره، فلما اعتقلوه فعلا (1984م) لم يتوقف التنظيم ولم يتأثر بغيابه، ثم لما خرج من الاعتقال أخذ إجازة سنة من التنظيم لئلا يتتبع اليهود أمر التنظيم، ثم لما عاد إلى التنظيم عاد جنديا لا في القيادة.
وكثير من مراحل المواجهة مع فتح أو السعي للتسلح أو غيره تم والشيخ ياسين في السجن أو خارج التنظيم. ولما اندلعت الانتفاضة كرر هذا الأسلوب، يقول: "اعتقلوا قبلي، واعترفوا عليَّ كمؤسس، واللي بدأ الانتفاضة، والسلطة (الإسرائيلية) من هنا وجدت أنه مش في مصلحتها تعتقلني، فسابتني في الخارج لكي تصطاده من حولي، وتعرف الأمور، أنا في تلك الفترة اعتزلت كل العمل، وتركت العمل لآخرين يشتغلوا في عمل الانتفاضة والخطة وكله كل شيء".
د. الانضباط والاتزان: اعتمد الشيخ ياسين نهج رصد وتصفية عملاء الاحتلال قبل نهج العمليات ضد الاحتلال نفسه، فأول عمليات الجهاز العسكري كانت محاولات كشف شبكات العملاء التابعين للإسرائيليين، وكانوا يقصدون القبض عليه والتحقيق معه لكشف شبكة العمالة، وكان التحقيق مع العميل يصوَّر ثم تعرض اعترافاته على لجنة تقوم بعملية التحليل والمحاكمة في نفس الوقت، قبل أن تصدر حكمها عليه، ولم يكونوا يقدمون على ذلك قبل الاشتباه الأكيد في أمره، واستطاعوا كشف العديد من الشبكات ومن أساليب الإسقاط. ومع ذلك، فهم لما قتلوا مشتبها به بالعمالة قبل أن يثبت عليه هذا بشكل قاطع دفعوا الدية لأهله.
ه. السرية: اعتمد الشيخ كذلك نهج السرية، فلم يكن يعلن لا عن تصفية عملاء، ولا في المرحلة التالية عن العمليات التي قاموا بها ضد الاحتلال أو المستوطنات، يقول: "ولم تكن بيانات، كنت أحب العمل وأُبْقي العدو تائها".
(5) درس في طبائع الشعوب
من بين كل كلام الشيخ علق بذهني هذه العبارات التي تمثل بحد ذاتها درسا في طبائع الشعوب التي يجب أن يفققها العاملون للإسلام، يفقهونها ليعملوا على بصيرة لا لينشغل بعضهم بشتم هذه الشعوب، يذكر الشيخ وهو يصف صعوبة البدايات أن الناس كانت تحب عبد الناصر وتكره الإخوان المسلمين في ذلك الوقت، حتى أنهم هتفوا لما مات "الله حي وناصر حي"، وذلك لأن "الدعاية المصرية في غرس المقاومة العربية في ذلك الوقت فظيعة جداً .. فظيعة جداً، لا تتصورها قد إيش"، و"كان الناس في ذهول عند موته" حتى إن بعض الخطباء لما خطب ضد عبد الناصر هاجمه الناس، ويحكي الشيخ عن رجل كبير جاءه بعد الخطبة واستنكر عليه عدم ثنائه وترحمه على عبد الناصر، وقال له: ماذا تريد من عبد الناصر؟ يطبق الإسلام أم يحارب إسرائيل، فقال الشيخ ياسين: "الاثنين واحد، إذا لم يأخذ الإسلام سلاحه معناه إنه مهزوم، ولذلك هو لم يؤدي الأمانة اللي ربنا استأمنه عليها".
ويضيف الشيخ أن الدعاية والإعلام يجعل الناس مخدرين، ويضرب مثلا على ذلك بحال الشعب المصري بعد هزيمة يونيو 1967، "كان الشعب المصري اللي طلع يهتف لعبد الناصر بعدما استقال .. طيب ما هو الثاني مخدر خالص، طيب.. واحد حقق هزيمة، وقال: أنا بأتحمل الهزيمة، وبيتحملها وبيرجع يمسك المسؤولية تاني، وبيهتفوله فمعناها برضه إن الشعب مخدر خالص، مافيش في العالم واحد بيتحمل هزيمة وبيرجع على الكرسي تاني، لكن هذا الواقع هو اللي صار في بلدنا".
نشر في ساسة بوست
حماس الجذور والميثاق، ضمن "الذخائر العظام" 1/852.
Published on March 31, 2016 23:06



