محمد إلهامي's Blog, page 46
May 21, 2016
موجز قصة النكبة (2)
بدأت القصة منذ 1896م، وتوقفنا في المقال السابق عند نهاية الحرب العالمية الثانية، حينئذ كانت الصورة في فلسطين بائسة على كل المستويات:
- فعلى المستوى الدولي: انتصر الحلفاء على دول المحور الذين تعلقت بهم الآمال العربية والفلسطينية، مما جعل مشروع الدولة الصهيونية سائرا بلا أي عرقلة سياسية، وقد قرأت الصهيونية الموقف سريعا فنقلت ثقل نشاطها واعتمادها من بريطانيا إلى أمريكا (1942م).
- وعلى المستوى الداخلي كانت الصهيونية ترسخ وجودها على الأرض بمستوى متصاعد، فقد تحولت عصابات الهاجاناه إلى جيش حقيقي بما تحصل لها من خبرة وعلوم عسكرية وأسلحة وعتاد من مشاركتها في الحرب العالمية الثانية إلى جوار بريطانيا، وكان الجهاز الأمني الصهيوني يتمّ خطته التفصيلية عن القرى الفلسطينية فيجمع عن كل قرية: نوعية الأرض والسكان والحالة الاقتصادية والاتجاهات السياسية ومدى سهولة أو صعوبة احتلال القرية، ويستزيد من صناعة العملاء ومراقبة المجتمع الفلسطيني وما بقي من مراكز تأثيره، وقد صارت له مؤسسات "إسلامية وطنية" لتشاغب على المؤسسات الحقيقية وتثير أزمات الفرقة بينها وصرف الناس عنها.
- وأما على المستوى الفلسطيني فقد كانت الحالة سيئة، فلم يزل المجتمع الفلسطيني يعاني من ضرب جيل المقاومة الذي استمرت ثورته بين (1936 – 1939م)، والتي أسفرت عن قتل خمسة آلاف فلسطينية وجرح أربعة عشر ألفا، وما صحب ذلك كله من تجريد السلاح وهدم البيوت، ومقتل القادة، ووجود القيادات السياسية بالخارج منقطعين عن أوضاع الداخل، مع التمزق العربي ووقوع بلدانه تحت الاحتلال.
كررت الصهيوينة الخطة القديمة، وضعت نفسها في خدمة القوة الدولية لتبلغ أهدافها، لكنها نقلت نشاطها من بريطانيا إلى أمريكا مع تغير موازين القوى فيما بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت أمريكا حينئذ ترث الوجود الإنجليزي والفرنسي في الشرق، فكانت الصهيونية هي ذراعها لإخراج الإنجليز من فلسطين، فانقلب الصهاينة على الإنجليز، وطالب مؤتمر الحركة الصهيونية الذي عقد في أطلنطا بأمريكا (1944م) بضرورة خروج الإنجليز من فلسطين وتوفير حماية دولية لليهود، ثم أشعل الصهاينة حرب عصابات ضد الجيش البريطاني نفسه، وقاموا بعدة عمليات تفجير واغتيال وخطف مؤثرة، حتى بلغ القتلى في صفوف البريطانيين 169 بين عامي (1946، 1947)، وعند نهاية سنوات الانتداب كانت العصابات الصهيونية قد نفذت خمسمائة عملية ضد الإنجليز، وكم كان مثيرا مشهد تشرشل –الذي كان أول من درب العصابات اليهودية قديما- وهو يعلن مرارته ويحذر وينذر في الأمم المتحدة، ولكنه التحذير الذي يعرف الجميع أنه أجوف!
وبرغم كل هذا تكاد بريطانيا أن تكون التزمت الصمت ولم ترد بشيء على الصهاينة، فقد صارت الصهيونية في الحماية الأمريكية، كما أن كثيرا من عناصر الشرطة والجيش الإنجليزي في فلسطين هم من اليهود والصهاينة أنفسهم. وذلك في نفس التوقيت الذي كانت تعتقل فيه الفلسطينيين لمجرد حيازة السلاح، حتى بلغ عدد المعتقلين (300) في النصف الأول من عام (1946م).
وعلى الجانب السياسي العالمي كانت الصهيونية تمول حملة الرئيس الأمريكي ترومان والذي كافأهم بعد فوزه بالموافقة على هجرة مائة ألف يهودي إلى فلسطين. كما كانت الصهيونية في أمريكا تجمع من اليهود تمويلا لإنشاء صناعات عسكرية في إسرائيل، وبهذا صارت عصابات الهاجاناه تصنع بعض أسلحتها بنفسها مما قوى مركزها الفعلي حتى ضد البريطانيين الذين اضطروا لإعلان مغادرتهم فلسطين بعد سنتين أي في عام (1948م).
بدأت عملية وراثة فلسطين من الإنجليز، اشترى اليهود من أسلحة الإنجليز بالمال ما لم يأخذوه بغير طريق الدعم، فكانت لديهم 24 طائرة اشتروها بخمسة ملايين جنيه، وعند بداية 1948 كانت الوكالة اليهودية تسيطر فعليا إداريا وعسكريا، ولديها جيش مقاتل يتكون من: عصابات الهاجاناه (35 ألفا) وعشرة آلاف مقاتل من الوحدات الخاصة، وتنظيمات عصابات الإرجون واشتيرن. وعملت هذه العصابات على تنفيذ خطة التهجير للفلسطينيين، فتنوعت عملياتهم بين الهجوم العسكري على القرى وتهجيرها، أو تفجير الأسواق والمحال، أو نصب الكمائن على الطرقات وقتل الفلسطينيين، أو تنفيذ عمليات خاصة قامت بها وحدات المستعربين التي ظهرت في تلك الفترة.
في اجتماع بتاريخ (10 مارس 1948م) لقيادة الهاجاناه، أي قبل نهاية الانتداب البريطاني بشهرين، أتموا الخطة التفصيلية للتعامل مع كل قرية فلسطينية يراد تهجيرها، وكانت الخطة تعتمد على الرعب أكثر من اعتمادها على التفوق العسكري، فلا بد من مذبحة أو ضربة هائلة تسفر عن خروج السكان من هولها قبل أن ينخرطوا في اشتباك أو مقاومة، وإذا وقع بعضهم في الأسر كانوا يقتلون بعضهم قبل نقلهم إلى معتقلات مركزية لتحقيق هدف الرعب وشل محاولة المقاومة، وإذا حوصرت القرية فهي تُحاصر من ثلاث جهات وتُقصف بغزارة ليهرب أهلها من الجهة الرابعة. وكانت خطة التهجير تبدأ من ساحل المتوسط وتمتد شرقا لكي يظل اتصال الدولة اللقيطة بالبحر، فكان أول المهجرين أهالي القرى والمدن الشمالية والغربية من فلسطين، ويقدر عدد المهجرين بثلاثمائة وخمسين ألف فلسطيني!
لقد أبدى الفلسطينيون مقاومة باسلة، لكنها مقاومة متبعثرة ومشتتة، تعاني من الفارق الضخم في القوة والتسلح، وتعاني من ضعف الكوادر الناتج عن سحق جيل الثورة قبل عشر سنوات، وتعاني من التواطأ العالمي لا سيما البريطاني، وتعاني من الخيانة العربية التي يحكم عواصمها عملاء يساعدون في قتلهم وإبادتهم، ولا تزال رسالة عبد القادر الحسيني إلى جامعة الدول العربية تختصر هذا المشهد "إني أحملكم المسؤولية بعد أ، تركتم جنودي في أوج انتصاراتهم بدون عون أو سلاح"، واستشهد بعد رسالته بثلاثة أيام (9 إبريل 1948م)، وبينما يشيع الناس جنازته، كانت قرية دير ياسين تتعرض للمذبحة.
عند يوم 14 مايو 1948م، غادر الحاكم البريطاني فلسطين، ونزلها بن جوريون، وأعلن "استقلال" دولة إسرائيل، وخلفه كانت تنتصب صورة كبيرة للمنظر المؤسس: تيودور هرتزل، الذي بذر البذرة ومات بعد ثمان سنوات، ثم تحقق حلمه بعد موته بأربعين سنة!
ومن هنا بدأت مرحلة جديدة في تاريخ فلسطين والعرب والمسلمين بل والعالم!
عندئذ سمحت بريطانيا بدخول القوات العربية الهزيلة عددا وسلاحا إلى فلسطين، كانت الجيوش السبعة لا تزيد عن 24 ألفا، وهم أقل من ثلث القوة العسكرية الصهيونية، إضافة إلى فارق التسلح والخبرة والتدريب، دخلت الجيوش العربية بشعار "تحرير فلسطين" ليرتسم بدخولها الجانب الآخر من المهزلة، فبالإضافة إلى هزالها عددا وعدة وخبرة فإنها تخضع لتوجيه أنظمة تخضع للاحتلال، وبقيادة إنجليزية (جلوب باشا قائد الجيش الأردني، ومساعدوه إنجليز)، فإما أنها جيوش لم تحارب، وإما أنها كانت تدخل إلى القرى لتجردها من السلاح ثم تنسحب في المعركة أمام القوة الصهيونية فتغدو القرية بلا سلاح، ثم يأتي الصهاينة فينفذون مذبحة جديدة تثير الرعب والفزع وتنتج موجة جديدة من الهجرة، وقد نفذ الصهاينة مذابح في اللد والرملة في ظل وجود الجيوش العربية ولم يحرك أحد منهم ساكنا، وفوق ذلك فإن سائر ما استطاع أن ينجزه المجاهدون المتطوعون تدخلت الأنظمة العربية نفسها لإيقافه وإنهائه إما بإصدار أوامر انسحاب أو بتعديلات الخطة أو بإيقاف التقدم أو حتى بسجن المجاهدين!
وهكذا سقطت فلسطين! ولم يكن نصيب العملاء في سقوطها بأقل من نصيب الصهاينة أو المحتلين!
لئن كان هرتزل هو صاحب الفكرة والبذرة الأولى، فيجب ألا ينسينا هذا جهود من تلاه، لا سيما هذا الثلاثي الخطير: حاييم وايزمان، هربرت صموئيل، بن جوريون!
لقد عمل هؤلاء الثلاثة على تطويع كافة الظروف الدولية والداخلية لخدمة خلق الدولة الصهيونية، وعملوا في نفس الوقت على ألا تكون إسرائيل مرتبطة ارتباطا كاملا بالمزاج السياسي الغربي، بل أسسوا للاستقلال اليهودي العسكري والاقتصادي والأمني، فتكون قوتهم الذاتية طرفا في معادلة السياسة، وبرغم ما يبثه هؤلاء من تحريض شعبي وديني لليهود فإنهم عملوا على خلق الظروف المواتية للدولة قبل نشوئها أو إعلانها، فلما جاءت لحظة الإعلان كانت إسرائيل أمرا واقعا!
ولئن كان هؤلاء يستحقون أن توضع أسماؤهم في سجل شرف الصهاينة، فيجب ألا ننسى أبدا أن آخرين يستحقون أن توضع أسماؤهم في سجل العار من دفتر العرب!
نشر في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية
- فعلى المستوى الدولي: انتصر الحلفاء على دول المحور الذين تعلقت بهم الآمال العربية والفلسطينية، مما جعل مشروع الدولة الصهيونية سائرا بلا أي عرقلة سياسية، وقد قرأت الصهيونية الموقف سريعا فنقلت ثقل نشاطها واعتمادها من بريطانيا إلى أمريكا (1942م).
- وعلى المستوى الداخلي كانت الصهيونية ترسخ وجودها على الأرض بمستوى متصاعد، فقد تحولت عصابات الهاجاناه إلى جيش حقيقي بما تحصل لها من خبرة وعلوم عسكرية وأسلحة وعتاد من مشاركتها في الحرب العالمية الثانية إلى جوار بريطانيا، وكان الجهاز الأمني الصهيوني يتمّ خطته التفصيلية عن القرى الفلسطينية فيجمع عن كل قرية: نوعية الأرض والسكان والحالة الاقتصادية والاتجاهات السياسية ومدى سهولة أو صعوبة احتلال القرية، ويستزيد من صناعة العملاء ومراقبة المجتمع الفلسطيني وما بقي من مراكز تأثيره، وقد صارت له مؤسسات "إسلامية وطنية" لتشاغب على المؤسسات الحقيقية وتثير أزمات الفرقة بينها وصرف الناس عنها.
- وأما على المستوى الفلسطيني فقد كانت الحالة سيئة، فلم يزل المجتمع الفلسطيني يعاني من ضرب جيل المقاومة الذي استمرت ثورته بين (1936 – 1939م)، والتي أسفرت عن قتل خمسة آلاف فلسطينية وجرح أربعة عشر ألفا، وما صحب ذلك كله من تجريد السلاح وهدم البيوت، ومقتل القادة، ووجود القيادات السياسية بالخارج منقطعين عن أوضاع الداخل، مع التمزق العربي ووقوع بلدانه تحت الاحتلال.
كررت الصهيوينة الخطة القديمة، وضعت نفسها في خدمة القوة الدولية لتبلغ أهدافها، لكنها نقلت نشاطها من بريطانيا إلى أمريكا مع تغير موازين القوى فيما بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت أمريكا حينئذ ترث الوجود الإنجليزي والفرنسي في الشرق، فكانت الصهيونية هي ذراعها لإخراج الإنجليز من فلسطين، فانقلب الصهاينة على الإنجليز، وطالب مؤتمر الحركة الصهيونية الذي عقد في أطلنطا بأمريكا (1944م) بضرورة خروج الإنجليز من فلسطين وتوفير حماية دولية لليهود، ثم أشعل الصهاينة حرب عصابات ضد الجيش البريطاني نفسه، وقاموا بعدة عمليات تفجير واغتيال وخطف مؤثرة، حتى بلغ القتلى في صفوف البريطانيين 169 بين عامي (1946، 1947)، وعند نهاية سنوات الانتداب كانت العصابات الصهيونية قد نفذت خمسمائة عملية ضد الإنجليز، وكم كان مثيرا مشهد تشرشل –الذي كان أول من درب العصابات اليهودية قديما- وهو يعلن مرارته ويحذر وينذر في الأمم المتحدة، ولكنه التحذير الذي يعرف الجميع أنه أجوف!
وبرغم كل هذا تكاد بريطانيا أن تكون التزمت الصمت ولم ترد بشيء على الصهاينة، فقد صارت الصهيونية في الحماية الأمريكية، كما أن كثيرا من عناصر الشرطة والجيش الإنجليزي في فلسطين هم من اليهود والصهاينة أنفسهم. وذلك في نفس التوقيت الذي كانت تعتقل فيه الفلسطينيين لمجرد حيازة السلاح، حتى بلغ عدد المعتقلين (300) في النصف الأول من عام (1946م).
وعلى الجانب السياسي العالمي كانت الصهيونية تمول حملة الرئيس الأمريكي ترومان والذي كافأهم بعد فوزه بالموافقة على هجرة مائة ألف يهودي إلى فلسطين. كما كانت الصهيونية في أمريكا تجمع من اليهود تمويلا لإنشاء صناعات عسكرية في إسرائيل، وبهذا صارت عصابات الهاجاناه تصنع بعض أسلحتها بنفسها مما قوى مركزها الفعلي حتى ضد البريطانيين الذين اضطروا لإعلان مغادرتهم فلسطين بعد سنتين أي في عام (1948م).
بدأت عملية وراثة فلسطين من الإنجليز، اشترى اليهود من أسلحة الإنجليز بالمال ما لم يأخذوه بغير طريق الدعم، فكانت لديهم 24 طائرة اشتروها بخمسة ملايين جنيه، وعند بداية 1948 كانت الوكالة اليهودية تسيطر فعليا إداريا وعسكريا، ولديها جيش مقاتل يتكون من: عصابات الهاجاناه (35 ألفا) وعشرة آلاف مقاتل من الوحدات الخاصة، وتنظيمات عصابات الإرجون واشتيرن. وعملت هذه العصابات على تنفيذ خطة التهجير للفلسطينيين، فتنوعت عملياتهم بين الهجوم العسكري على القرى وتهجيرها، أو تفجير الأسواق والمحال، أو نصب الكمائن على الطرقات وقتل الفلسطينيين، أو تنفيذ عمليات خاصة قامت بها وحدات المستعربين التي ظهرت في تلك الفترة.
في اجتماع بتاريخ (10 مارس 1948م) لقيادة الهاجاناه، أي قبل نهاية الانتداب البريطاني بشهرين، أتموا الخطة التفصيلية للتعامل مع كل قرية فلسطينية يراد تهجيرها، وكانت الخطة تعتمد على الرعب أكثر من اعتمادها على التفوق العسكري، فلا بد من مذبحة أو ضربة هائلة تسفر عن خروج السكان من هولها قبل أن ينخرطوا في اشتباك أو مقاومة، وإذا وقع بعضهم في الأسر كانوا يقتلون بعضهم قبل نقلهم إلى معتقلات مركزية لتحقيق هدف الرعب وشل محاولة المقاومة، وإذا حوصرت القرية فهي تُحاصر من ثلاث جهات وتُقصف بغزارة ليهرب أهلها من الجهة الرابعة. وكانت خطة التهجير تبدأ من ساحل المتوسط وتمتد شرقا لكي يظل اتصال الدولة اللقيطة بالبحر، فكان أول المهجرين أهالي القرى والمدن الشمالية والغربية من فلسطين، ويقدر عدد المهجرين بثلاثمائة وخمسين ألف فلسطيني!
لقد أبدى الفلسطينيون مقاومة باسلة، لكنها مقاومة متبعثرة ومشتتة، تعاني من الفارق الضخم في القوة والتسلح، وتعاني من ضعف الكوادر الناتج عن سحق جيل الثورة قبل عشر سنوات، وتعاني من التواطأ العالمي لا سيما البريطاني، وتعاني من الخيانة العربية التي يحكم عواصمها عملاء يساعدون في قتلهم وإبادتهم، ولا تزال رسالة عبد القادر الحسيني إلى جامعة الدول العربية تختصر هذا المشهد "إني أحملكم المسؤولية بعد أ، تركتم جنودي في أوج انتصاراتهم بدون عون أو سلاح"، واستشهد بعد رسالته بثلاثة أيام (9 إبريل 1948م)، وبينما يشيع الناس جنازته، كانت قرية دير ياسين تتعرض للمذبحة.
عند يوم 14 مايو 1948م، غادر الحاكم البريطاني فلسطين، ونزلها بن جوريون، وأعلن "استقلال" دولة إسرائيل، وخلفه كانت تنتصب صورة كبيرة للمنظر المؤسس: تيودور هرتزل، الذي بذر البذرة ومات بعد ثمان سنوات، ثم تحقق حلمه بعد موته بأربعين سنة!
ومن هنا بدأت مرحلة جديدة في تاريخ فلسطين والعرب والمسلمين بل والعالم!
عندئذ سمحت بريطانيا بدخول القوات العربية الهزيلة عددا وسلاحا إلى فلسطين، كانت الجيوش السبعة لا تزيد عن 24 ألفا، وهم أقل من ثلث القوة العسكرية الصهيونية، إضافة إلى فارق التسلح والخبرة والتدريب، دخلت الجيوش العربية بشعار "تحرير فلسطين" ليرتسم بدخولها الجانب الآخر من المهزلة، فبالإضافة إلى هزالها عددا وعدة وخبرة فإنها تخضع لتوجيه أنظمة تخضع للاحتلال، وبقيادة إنجليزية (جلوب باشا قائد الجيش الأردني، ومساعدوه إنجليز)، فإما أنها جيوش لم تحارب، وإما أنها كانت تدخل إلى القرى لتجردها من السلاح ثم تنسحب في المعركة أمام القوة الصهيونية فتغدو القرية بلا سلاح، ثم يأتي الصهاينة فينفذون مذبحة جديدة تثير الرعب والفزع وتنتج موجة جديدة من الهجرة، وقد نفذ الصهاينة مذابح في اللد والرملة في ظل وجود الجيوش العربية ولم يحرك أحد منهم ساكنا، وفوق ذلك فإن سائر ما استطاع أن ينجزه المجاهدون المتطوعون تدخلت الأنظمة العربية نفسها لإيقافه وإنهائه إما بإصدار أوامر انسحاب أو بتعديلات الخطة أو بإيقاف التقدم أو حتى بسجن المجاهدين!
وهكذا سقطت فلسطين! ولم يكن نصيب العملاء في سقوطها بأقل من نصيب الصهاينة أو المحتلين!
لئن كان هرتزل هو صاحب الفكرة والبذرة الأولى، فيجب ألا ينسينا هذا جهود من تلاه، لا سيما هذا الثلاثي الخطير: حاييم وايزمان، هربرت صموئيل، بن جوريون!
لقد عمل هؤلاء الثلاثة على تطويع كافة الظروف الدولية والداخلية لخدمة خلق الدولة الصهيونية، وعملوا في نفس الوقت على ألا تكون إسرائيل مرتبطة ارتباطا كاملا بالمزاج السياسي الغربي، بل أسسوا للاستقلال اليهودي العسكري والاقتصادي والأمني، فتكون قوتهم الذاتية طرفا في معادلة السياسة، وبرغم ما يبثه هؤلاء من تحريض شعبي وديني لليهود فإنهم عملوا على خلق الظروف المواتية للدولة قبل نشوئها أو إعلانها، فلما جاءت لحظة الإعلان كانت إسرائيل أمرا واقعا!
ولئن كان هؤلاء يستحقون أن توضع أسماؤهم في سجل شرف الصهاينة، فيجب ألا ننسى أبدا أن آخرين يستحقون أن توضع أسماؤهم في سجل العار من دفتر العرب!
نشر في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية
Published on May 21, 2016 02:10
May 19, 2016
من أين تبدأ دراسة الحضارة
يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي: "كانت هذه الحضارة (الغربية)، بمعناها الواسع، مجموع عقائد ومناهج فكرية، وفلسفات ونظم سياسية واقتصادية، وعلوما طبيعية وعمرانية واجتماعية، وتجارب خاصة مرت بها الشعوب الأوروبية التي تزعمت هذه الحضارة في رحلتها الطويلة، وكانت مظهر تقدم العلم البشري وعلوم الطبيعة، وعلم الآلات والعلوم الرياضية، ومجموع نتائج جهود علماء وباحثين عبر القرون؛ فكانت مزيجا غريبا من أجزاء لا يكون الحكم عليها واحدا متشابها""إن من أصعب العمليات وأدقها هو تحليل الحضارة التي اختمرت تحليلا كيميائيا وفرز العناصر التي دخلت فيها في عهود مختلفة، وفترات تاريخية معينة، وإرجاعها إلى أصلها ومصدرها، وتحديد مقاديرها ومداها من التأثير والقبول، وتعيين من يرجع إليه الفضل في هذا العطاء الحضاري والتغيير الجذري"وإذا كان ثمة طوفان من المعلومات تفنى الأعمار دون الإحاطة بشيء منه، فقد كان حتما أن تنشأ تخصصات، وأن يكون بعضها أهم من بعض، وأدلَّ على الحقيقة من بعض، ومن ثم فلا بد من أن تكون أولويات للدراسة، خصوصا مع ضخامة التحدي وأهمية الإنجاز.
1. العقائد والفلسفة
ومن المنطلق الإسلامي الذي نعتمده أصلا وأساسا ومعيارا، فإننا لا نجد صعوبة في أن نبدأ من "العقائد والفلسفة"، فالعقيدة هي أصل الأصول وهي القضية المحورية وهي التي تهيمن على نصوص القرآن الكريم والحديث الشريف، وقد استغرق تأسيس العقيدة والدعوة إليها الوقت الأطول في عمر البعثة النبوية (13 عاما)، وهي التي يُحاسب الله عليها يوم القيامة، فكل الأعمال تبع لها، {إنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا} [النساء: 116].
وهذه الحقيقة تبدو من الوضوح والسطوع بحيث أقَرَّ بها من لا يؤمنون بهداية القرآن ولا يعتمدون المنطلق الإسلامي كأصل يُصدر عنه ويُرجع إليه، فالحضارات الكبرى إنما تأسست على الديانات الكبرى كما لاحظ بحق المؤرخ البريطاني كريستوفر داوسونومن ثَمَّ فإن محاولة دراسة أي موضوع إنساني بعيدا عن الدين هي نوع من العبث! فكيف إذا كان الموضوع هو الحضارة التي هي مجمع النشاط الإنساني وخلاصته؟!
والدين الذي نعنيه هو "العقيدة" و"الفكرة المهيمنة"، فالدين في حقيقته هو فكرة رسخت وتعمقت حتى انعقد عليها القلب فصارت "عقيدة"، حتى لو كانت هذه العقيدة هي "اللا دين"! ومن المهم أن ندرك أن الانخلاع الغربي من المسيحية لم يكن في حقيقته انخلاعا بقدر ما كان اعتناقا لدين جديد وفكرة جديدة، إذ لا يسع الإنسان أن يظل بلا أفكار، وسواء قلنا إن هذا الدين الجديد هو "العلم" أو "المادية" أو حتى "النسبية في العقائد"، فكل ذلك لا يغير من حقيقة أن كل هذه المسميات إنما هي في عمقها "دين" أيضا!
وخروجا من الخلاف والتشويش الذي ينتج عن لفظة "دين"، نستعمل لفظ "العقيدة" أو "الفلسفة" أو "الثقافة" أحيانا، والمقصود في كل الأحوال: أن أي دراسة للحضارة يجب أن تبدأ من هنا.
2. التاريخ
ونعني به التاريخ الحضاري لا السياسي فحسب، وإن كان التاريخ السياسي هو أقوى المؤثرات في تواريخ الأمم، والتاريخ الحضاري هو تاريخ الأفكار والنظم والعلوم والآداب والفنون، وهو مرتبط بالجغرافيا والبيئة، فهو في النهاية الترجمة الحقيقية والأمينة لهذه الحضارة: هويةً وطموحا وطبائع، وكما يقول د. جمال حمدان بعبارة بليغة: "من الواضح كذلك إلى حد البديهي أن دراسة الشخصية الإقليمية لا تقتصر على الحاضر وإنما هي تترامى بعيدا عن عبر الماضي، وخلال التاريخ، لأنه بالدور التاريخي وحده يمكن التعرف على الفاعلية الإيجابية للإقليم وعلى التعبير الحر عن الشخصية الإقليمية. فالبيئة قد تكون في بعض الأحيان خرساء، ولكنها تنطق من خلال الإنسان، ولربما كانت الجغرافيا أحيانا صماء، ولكن ما أكثر ما كان التاريخ لسانها. ولقد قيل بحق إن التاريخ ظل الإنسان على الأرض. بمثل ما أن الجغرافيا ظل الأرض على الزمان، بينما يضيف قولٌ آخر إن معظم التاريخ إن لم يكن جغرافية متحركة، فإن بعضه على الأقل جغرافية متنكرة"إن العقائد والفلسفة تضطرنا -أول ما تضطرنا- إلى دراسة المؤسسين والأبطال الذين كانت أعمالهم منعطفات مؤثرة في مسيرة الأمم، ولا يسعنا أن نفهم هؤلاء ولا أن نقدر أعمالهم بغير دراسة متعمقة لتاريخهم والظروف التي أحاطت بهم. ولئن كان الرسل والأنبياء أنفسهم -وهم الذين ارتبطوا بالسماء فكانوا أولى الناس ألا يتأثروا بشيء من الأرض ومن الزمن- قد بُعثوا وهم يحملون بعض خصائص أقوامهم3. النظام السياسي
فالسياسة هي أكثر العوامل تأثيرا في الناس، وهي المهيمنة على كافة الأنشطة الأخرى.
وبرغم أنها منبثقة من "العقيدة" إلا أنها الأقدر على تنفيذ تعاليمها وترجمتها إلى أفعال ومؤسسات ونظم وطرائق، كذلك قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: "إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"كذلك فبرغم أنها منبثقة من "العقيدة" إلا أنها الأقدر على تحريف هذه العقيدة والانحراف عن هذه الفلسفة، وقد جاء في حديث النبي r: "... وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين"وهل أفسدَ الدينَ إلا الملوكُ ... وأحبار سوء ورهبانها؟
وفي خلاصة تاريخية بديعة يقول ابن كثير: "كانت همة الوليد في البناء، وكان الناس كذلك يلقى الرجل الرجل فيقول: ماذا بنيت؟ ماذا عمرت؟ وكانت همة أخيه سليمان في النساء، وكان الناس كذلك، يلقى الرجل الرجل فيقول: كم تزوجت؟ ماذا عندك من السراري؟ وكانت همة عمر بن عبد العزيز في قراءة القرآن، وفي الصلاة والعبادة، وكان الناس كذلك، يلقى الرجل الرجل فيقول: كم وردك؟ كم تقرأ كل يوم؟ ماذا صليت البارحة؟ والناس يقولون: الناس على دين مليكهم، إن كان خمارا كثر الخمر، وإن كان لوطيا فكذلك وإن كان شحيحا حريصا كان الناس كذلك، وإن كان جوادا كريما شجاعا كان الناس كذلك، وإن كان طماعا ظلوما غشوما فكذلك، وإن كان ذا دين وتقوى وبر وإحسان كان الناس كذلك"وإذا كان الحاكم في الممالك القديمة يستطيع التأثير بما يصبغ المملكة على نمطه حتى في الممالك القديمة، فكيف يبلغ التأثير الآن بعد أن صارت السلطة -منذ عصر الدولة المركزية- قوة خارقة لم يُؤتها ملك أو سلطان من قبل؟! لقد صارت السلطة تمتلك من وسائل التأثير عبر الإعلام والقوانين ما يمكنها من دخول كل بيت والتحكم في كل نشاط، حتى لتستطيع السلطة صُنع جمهور على نمطها وقالبها، بالرغبة والرهبة، لا سيما إن كانت مستبدة، حتى قال جمال الدين الأفغاني: لا يصلح في الشرق "كما تكونوا يولى عليكم"، ولكن: "كما يولى عليكم تكونون".
ثم إن السياسة تتحكم في واقعنا، هنا والآن، أي أن دراستها تمدنا بتوصيات سريعة لمعالجة قضايا اللحظة الراهنة، وتحقيق استجابة لتحديات الواقع.
فهذه الثلاثة: العقائد والفلسفة، التاريخ، السياسة هي -بحسب ما نرى- أولويات الاستغراب (دراسة الغرب) التي يجب أن يُبدأ منها، وهي تشتمل من وجوه كثيرة على باقي مجالات الاستغراب كالنظام الاجتماعي والاقتصادي والقانوني والشعر والأدب والفنون، فكل هذا إما متأثر بشكل مباشر بواحد من هذه الثلاثة أو أن دراسة هذه الثلاثة تُلزم بجمع مادة أصيلة ووافية عن باقي هذه المجالات.
نشر في ساسة بوست
الندوي: موقف العالم الإسلامي تجاه الحضارة الغربية ص10. الندوي: الإسلام أثره على الحضارة وفضله على الإنسانية ص12، 13. Christopher Dawson: The Dynamics Of World History, p. 128 وهذه هي خلاصة كتابها (The Case Of God) والذي صدر في سبتمبر 2009، وترجم إلى العربية بعنوان «الله لماذا»، ونشرته دار سطور في القاهرة. وبعده بشهرين في (نوفمبر 2009م) نُشِر كتاب الصحفي الإنجليزي نيكولاس واد، الذي جعل له عنوانا موحيا «غريزة الإيمان» (The Faith Instinct)، وفيه يتحدث عن الإنسان مخلوق وداخله «جين» الله. وقبلهما كان دين هامر قد كتب كتابه الشهير الذي أثار زوبعة في وقته (سبتمبر 2004م) «الجين الإلهي» (The God Gene) لأنه قال بوجود جينات في جسم الإنسان هي المسئولة عن تعلقه بالروحانيات، وكان العنوان التوضيحي للكتاب «How Faith is Hardwired into our Genes» أي «كيف أن الإيمان مستقر في جيناتنا». ول ديورانت: قصة الحضارة 1/98، 99. جوستاف لوبون: روح الاجتماع ص9، 10. حسن حنفي: مقدمة في علم الاستغراب ص101. د. جمال حمدان: شخصية مصر 1/13. بعث الله تعالى الأنبياء من صميم أقوامهم {مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [آل عمران: 164] {وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا} {وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا} {وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا} [الأعراف: 65، 73، 85] ويتكلم بلغتهم {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} [إبراهيم: 4] ويعرف شؤونهم فيدعوهم إلى ترك ما هم عليه من الضلالة. المبرد: الكامل في اللغة والأدب 1/214، ابن تيمية: مجموع الفتاوى 11/416. الثعالبي: التمثيل والمحاضرة ص131، الميداني: مجمع الأمثال 2/358. أحمد (17156)، وأبو داود (4252)، والترمذي (2229)، وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة 4/110) وشعيب الأرناؤوط. الدارمي (214)، وصححه الألباني (مشكاة المصابيح: 269). ابن كثير: البداية والنهاية 9/186.
1. العقائد والفلسفة
ومن المنطلق الإسلامي الذي نعتمده أصلا وأساسا ومعيارا، فإننا لا نجد صعوبة في أن نبدأ من "العقائد والفلسفة"، فالعقيدة هي أصل الأصول وهي القضية المحورية وهي التي تهيمن على نصوص القرآن الكريم والحديث الشريف، وقد استغرق تأسيس العقيدة والدعوة إليها الوقت الأطول في عمر البعثة النبوية (13 عاما)، وهي التي يُحاسب الله عليها يوم القيامة، فكل الأعمال تبع لها، {إنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا} [النساء: 116].
وهذه الحقيقة تبدو من الوضوح والسطوع بحيث أقَرَّ بها من لا يؤمنون بهداية القرآن ولا يعتمدون المنطلق الإسلامي كأصل يُصدر عنه ويُرجع إليه، فالحضارات الكبرى إنما تأسست على الديانات الكبرى كما لاحظ بحق المؤرخ البريطاني كريستوفر داوسونومن ثَمَّ فإن محاولة دراسة أي موضوع إنساني بعيدا عن الدين هي نوع من العبث! فكيف إذا كان الموضوع هو الحضارة التي هي مجمع النشاط الإنساني وخلاصته؟!
والدين الذي نعنيه هو "العقيدة" و"الفكرة المهيمنة"، فالدين في حقيقته هو فكرة رسخت وتعمقت حتى انعقد عليها القلب فصارت "عقيدة"، حتى لو كانت هذه العقيدة هي "اللا دين"! ومن المهم أن ندرك أن الانخلاع الغربي من المسيحية لم يكن في حقيقته انخلاعا بقدر ما كان اعتناقا لدين جديد وفكرة جديدة، إذ لا يسع الإنسان أن يظل بلا أفكار، وسواء قلنا إن هذا الدين الجديد هو "العلم" أو "المادية" أو حتى "النسبية في العقائد"، فكل ذلك لا يغير من حقيقة أن كل هذه المسميات إنما هي في عمقها "دين" أيضا!
وخروجا من الخلاف والتشويش الذي ينتج عن لفظة "دين"، نستعمل لفظ "العقيدة" أو "الفلسفة" أو "الثقافة" أحيانا، والمقصود في كل الأحوال: أن أي دراسة للحضارة يجب أن تبدأ من هنا.
2. التاريخ
ونعني به التاريخ الحضاري لا السياسي فحسب، وإن كان التاريخ السياسي هو أقوى المؤثرات في تواريخ الأمم، والتاريخ الحضاري هو تاريخ الأفكار والنظم والعلوم والآداب والفنون، وهو مرتبط بالجغرافيا والبيئة، فهو في النهاية الترجمة الحقيقية والأمينة لهذه الحضارة: هويةً وطموحا وطبائع، وكما يقول د. جمال حمدان بعبارة بليغة: "من الواضح كذلك إلى حد البديهي أن دراسة الشخصية الإقليمية لا تقتصر على الحاضر وإنما هي تترامى بعيدا عن عبر الماضي، وخلال التاريخ، لأنه بالدور التاريخي وحده يمكن التعرف على الفاعلية الإيجابية للإقليم وعلى التعبير الحر عن الشخصية الإقليمية. فالبيئة قد تكون في بعض الأحيان خرساء، ولكنها تنطق من خلال الإنسان، ولربما كانت الجغرافيا أحيانا صماء، ولكن ما أكثر ما كان التاريخ لسانها. ولقد قيل بحق إن التاريخ ظل الإنسان على الأرض. بمثل ما أن الجغرافيا ظل الأرض على الزمان، بينما يضيف قولٌ آخر إن معظم التاريخ إن لم يكن جغرافية متحركة، فإن بعضه على الأقل جغرافية متنكرة"إن العقائد والفلسفة تضطرنا -أول ما تضطرنا- إلى دراسة المؤسسين والأبطال الذين كانت أعمالهم منعطفات مؤثرة في مسيرة الأمم، ولا يسعنا أن نفهم هؤلاء ولا أن نقدر أعمالهم بغير دراسة متعمقة لتاريخهم والظروف التي أحاطت بهم. ولئن كان الرسل والأنبياء أنفسهم -وهم الذين ارتبطوا بالسماء فكانوا أولى الناس ألا يتأثروا بشيء من الأرض ومن الزمن- قد بُعثوا وهم يحملون بعض خصائص أقوامهم3. النظام السياسي
فالسياسة هي أكثر العوامل تأثيرا في الناس، وهي المهيمنة على كافة الأنشطة الأخرى.
وبرغم أنها منبثقة من "العقيدة" إلا أنها الأقدر على تنفيذ تعاليمها وترجمتها إلى أفعال ومؤسسات ونظم وطرائق، كذلك قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: "إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"كذلك فبرغم أنها منبثقة من "العقيدة" إلا أنها الأقدر على تحريف هذه العقيدة والانحراف عن هذه الفلسفة، وقد جاء في حديث النبي r: "... وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين"وهل أفسدَ الدينَ إلا الملوكُ ... وأحبار سوء ورهبانها؟
وفي خلاصة تاريخية بديعة يقول ابن كثير: "كانت همة الوليد في البناء، وكان الناس كذلك يلقى الرجل الرجل فيقول: ماذا بنيت؟ ماذا عمرت؟ وكانت همة أخيه سليمان في النساء، وكان الناس كذلك، يلقى الرجل الرجل فيقول: كم تزوجت؟ ماذا عندك من السراري؟ وكانت همة عمر بن عبد العزيز في قراءة القرآن، وفي الصلاة والعبادة، وكان الناس كذلك، يلقى الرجل الرجل فيقول: كم وردك؟ كم تقرأ كل يوم؟ ماذا صليت البارحة؟ والناس يقولون: الناس على دين مليكهم، إن كان خمارا كثر الخمر، وإن كان لوطيا فكذلك وإن كان شحيحا حريصا كان الناس كذلك، وإن كان جوادا كريما شجاعا كان الناس كذلك، وإن كان طماعا ظلوما غشوما فكذلك، وإن كان ذا دين وتقوى وبر وإحسان كان الناس كذلك"وإذا كان الحاكم في الممالك القديمة يستطيع التأثير بما يصبغ المملكة على نمطه حتى في الممالك القديمة، فكيف يبلغ التأثير الآن بعد أن صارت السلطة -منذ عصر الدولة المركزية- قوة خارقة لم يُؤتها ملك أو سلطان من قبل؟! لقد صارت السلطة تمتلك من وسائل التأثير عبر الإعلام والقوانين ما يمكنها من دخول كل بيت والتحكم في كل نشاط، حتى لتستطيع السلطة صُنع جمهور على نمطها وقالبها، بالرغبة والرهبة، لا سيما إن كانت مستبدة، حتى قال جمال الدين الأفغاني: لا يصلح في الشرق "كما تكونوا يولى عليكم"، ولكن: "كما يولى عليكم تكونون".
ثم إن السياسة تتحكم في واقعنا، هنا والآن، أي أن دراستها تمدنا بتوصيات سريعة لمعالجة قضايا اللحظة الراهنة، وتحقيق استجابة لتحديات الواقع.
فهذه الثلاثة: العقائد والفلسفة، التاريخ، السياسة هي -بحسب ما نرى- أولويات الاستغراب (دراسة الغرب) التي يجب أن يُبدأ منها، وهي تشتمل من وجوه كثيرة على باقي مجالات الاستغراب كالنظام الاجتماعي والاقتصادي والقانوني والشعر والأدب والفنون، فكل هذا إما متأثر بشكل مباشر بواحد من هذه الثلاثة أو أن دراسة هذه الثلاثة تُلزم بجمع مادة أصيلة ووافية عن باقي هذه المجالات.
نشر في ساسة بوست
الندوي: موقف العالم الإسلامي تجاه الحضارة الغربية ص10. الندوي: الإسلام أثره على الحضارة وفضله على الإنسانية ص12، 13. Christopher Dawson: The Dynamics Of World History, p. 128 وهذه هي خلاصة كتابها (The Case Of God) والذي صدر في سبتمبر 2009، وترجم إلى العربية بعنوان «الله لماذا»، ونشرته دار سطور في القاهرة. وبعده بشهرين في (نوفمبر 2009م) نُشِر كتاب الصحفي الإنجليزي نيكولاس واد، الذي جعل له عنوانا موحيا «غريزة الإيمان» (The Faith Instinct)، وفيه يتحدث عن الإنسان مخلوق وداخله «جين» الله. وقبلهما كان دين هامر قد كتب كتابه الشهير الذي أثار زوبعة في وقته (سبتمبر 2004م) «الجين الإلهي» (The God Gene) لأنه قال بوجود جينات في جسم الإنسان هي المسئولة عن تعلقه بالروحانيات، وكان العنوان التوضيحي للكتاب «How Faith is Hardwired into our Genes» أي «كيف أن الإيمان مستقر في جيناتنا». ول ديورانت: قصة الحضارة 1/98، 99. جوستاف لوبون: روح الاجتماع ص9، 10. حسن حنفي: مقدمة في علم الاستغراب ص101. د. جمال حمدان: شخصية مصر 1/13. بعث الله تعالى الأنبياء من صميم أقوامهم {مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [آل عمران: 164] {وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا} {وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا} {وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا} [الأعراف: 65، 73، 85] ويتكلم بلغتهم {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} [إبراهيم: 4] ويعرف شؤونهم فيدعوهم إلى ترك ما هم عليه من الضلالة. المبرد: الكامل في اللغة والأدب 1/214، ابن تيمية: مجموع الفتاوى 11/416. الثعالبي: التمثيل والمحاضرة ص131، الميداني: مجمع الأمثال 2/358. أحمد (17156)، وأبو داود (4252)، والترمذي (2229)، وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة 4/110) وشعيب الأرناؤوط. الدارمي (214)، وصححه الألباني (مشكاة المصابيح: 269). ابن كثير: البداية والنهاية 9/186.
Published on May 19, 2016 15:22
May 18, 2016
كيف تأسس حزب العدالة والتنمية التركي
تناولنا في المقالات السابقة: قصة المؤسس، وفريقالمؤسسين، والانفصال عن حزب الفضيلة، والرؤية الفكرية.. ونرى في السطور القادمة كيف عالج حزب العدالة والتنمية تحديات: الكوادر البشرية، والأموال، وبرنامج الحزب.
الكوادر
توحي روايات من كتبوا عن تجربة الحزب أنه لم تكن ثمة معاناة في مسألة الكوادر، ذلك أن شعبية أردوغان من جهة ثم إغلاق حزب الفضيلة من جهة أخرى وفَّر للحزب كثيرا من الكوادر ساعة انطلاقتهواهتم البرنامج اهتماما خاصا بالملف الاقتصادي الذي كان "واجب الوقت" وأكثر الملفات إلحاحا، لما وقعت فيه تركيا من أزمة تضخم كبرى أسفرت ضمن أمور أخرى عن الانتخابات المبكرة، وقد تولى هذا الملف علي باباجان، وهو رجل اقتصاد من عائلة لا تعمل بالسياسة ولم يتعرف على أردوغان إلا في مرحلة متأخرة، وكانت أبرز العوائق التي تواجههم وينبغي وضعها في البرنامج: الديون، صندوق النقد الدولي، السوق التركي المضطربةوكانت من أبرز ملامح البرنامج وضع "خطة الأعمال العاجلة" التي تحدد برنامج الأيام الأولى، فقد حضَّروا في فترة التأسيس "عشرات من المشاريع الإصلاحية الجاهزة للتنفيذ فورا"وأكثر ما لفت أنظار المراقبين في البرنامج هو الرغبة الصريحة الواضحة في الانضمام للاتحاد الأوروبي والتي تعبر عن مفارقة للفكر المعتاد للأحزاب الإسلامية السابقةفوض أردوغان صديقه رجل الأعمال جنيد زابصو في اختراق هذه فئة رجال الأعمال، ووعده بأن أي شخص سيأتي به منهم سيجعله في مجلس المؤسسين، وقد نجح جنيد في ضم عشرين منهم وُصِفوا بأنهم يساوون مليار دولار، كذلك كان الباب مفتوحا أمام مساعدات "أصحاب المحال الصغيرة، ومن التجار، ومن المتبرعين" الذين يمثلون القاعدة الشعبية الكبرى للحزب، مع الحرص على الابتعاد عن رؤوس الأموال التي تحاول شراء نفوذ سياسيإلا أن أهم ما في الموضوع هو في كون الحزب قد طرح نفسه باعتباره ديمقراطيا محافظا يمثل يمين الوسط ومنشقا عن الفكر السياسي الذي مثَّله أربكان، فلقد فتح هذا طريقا أمام عدد كبير من رجال الأعمال المتدينين "الشبابوقد "كانت هناك أوساط –منها (جمعية توسياد) التي تمثل اتحاد رجال الأعمال الأتراك- على استعداد لدعم كيانات جديدة يمكنها أن تملأ الفراغ السياسي للحكومة المركزية، ويمكنها أيضا أن تجد إجابة للبحث عن هوية أكثر ليبرالية، وأكثر جماعية، ومستقلة في الوقت نفسه عن مفهوم الفكر الوطني الذي رجح أن يظل صامتا حتى يتلاشى غضب انقلاب 28 فبراير"في المقال القادم بإذن الله تعالى، ننظر كيف اجتاز الحزب تحديات: الجمهور والقاعدة الشعبية، وكيف تعامل مع الواقع الإقليمي والدولي عند لحظة التأسيس، فالله المستعان.
نشر في تركيا بوست
Cemal Karakas: Turkey, Islam and Laicism, p. 29. Aydin, Çakır: Political Islam in Turkey, p. 2. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص336. برنامج تحت المجهر: "العثمانيون الجدد"، قناة الجزيرة، بتاريخ 26 يوليو 2007 Aydin, Çakır: Political Islam in Turkey, p. 2. Aydin, Çakır: Political Islam in Turkey, p. 2. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص323. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص365 وما بعدها. Cemal Karakas: Turkey, Islam and Laicism, p. 29. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص369. برنامج تحت المجهر: "العثمانيون الجدد"، قناة الجزيرة، بتاريخ 26 يوليو 2007 بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص370. http://www.akparti.org.tr/english/akp... بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص312، 337. أبرزهم: مجاهد أرسلان، عمر تشاليك، فاروق كوجا، أحمد توبراق، يافوز سليم أراس. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص307. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص307؛ Ömer Taspinar: Turkey’s Middle East Policies, p. 13; Cemal Karakas: Turkey, Islam and Laicism, p. 28. Heinz Kramer: A Changing Turkey, p. 67-8; ; Cemal Karakas: Turkey, Islam and Laicism, p. 20-1. Rabasa, Larrabee: The Rise of Political Islam, p. 52-3. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص308.
الكوادر
توحي روايات من كتبوا عن تجربة الحزب أنه لم تكن ثمة معاناة في مسألة الكوادر، ذلك أن شعبية أردوغان من جهة ثم إغلاق حزب الفضيلة من جهة أخرى وفَّر للحزب كثيرا من الكوادر ساعة انطلاقتهواهتم البرنامج اهتماما خاصا بالملف الاقتصادي الذي كان "واجب الوقت" وأكثر الملفات إلحاحا، لما وقعت فيه تركيا من أزمة تضخم كبرى أسفرت ضمن أمور أخرى عن الانتخابات المبكرة، وقد تولى هذا الملف علي باباجان، وهو رجل اقتصاد من عائلة لا تعمل بالسياسة ولم يتعرف على أردوغان إلا في مرحلة متأخرة، وكانت أبرز العوائق التي تواجههم وينبغي وضعها في البرنامج: الديون، صندوق النقد الدولي، السوق التركي المضطربةوكانت من أبرز ملامح البرنامج وضع "خطة الأعمال العاجلة" التي تحدد برنامج الأيام الأولى، فقد حضَّروا في فترة التأسيس "عشرات من المشاريع الإصلاحية الجاهزة للتنفيذ فورا"وأكثر ما لفت أنظار المراقبين في البرنامج هو الرغبة الصريحة الواضحة في الانضمام للاتحاد الأوروبي والتي تعبر عن مفارقة للفكر المعتاد للأحزاب الإسلامية السابقةفوض أردوغان صديقه رجل الأعمال جنيد زابصو في اختراق هذه فئة رجال الأعمال، ووعده بأن أي شخص سيأتي به منهم سيجعله في مجلس المؤسسين، وقد نجح جنيد في ضم عشرين منهم وُصِفوا بأنهم يساوون مليار دولار، كذلك كان الباب مفتوحا أمام مساعدات "أصحاب المحال الصغيرة، ومن التجار، ومن المتبرعين" الذين يمثلون القاعدة الشعبية الكبرى للحزب، مع الحرص على الابتعاد عن رؤوس الأموال التي تحاول شراء نفوذ سياسيإلا أن أهم ما في الموضوع هو في كون الحزب قد طرح نفسه باعتباره ديمقراطيا محافظا يمثل يمين الوسط ومنشقا عن الفكر السياسي الذي مثَّله أربكان، فلقد فتح هذا طريقا أمام عدد كبير من رجال الأعمال المتدينين "الشبابوقد "كانت هناك أوساط –منها (جمعية توسياد) التي تمثل اتحاد رجال الأعمال الأتراك- على استعداد لدعم كيانات جديدة يمكنها أن تملأ الفراغ السياسي للحكومة المركزية، ويمكنها أيضا أن تجد إجابة للبحث عن هوية أكثر ليبرالية، وأكثر جماعية، ومستقلة في الوقت نفسه عن مفهوم الفكر الوطني الذي رجح أن يظل صامتا حتى يتلاشى غضب انقلاب 28 فبراير"في المقال القادم بإذن الله تعالى، ننظر كيف اجتاز الحزب تحديات: الجمهور والقاعدة الشعبية، وكيف تعامل مع الواقع الإقليمي والدولي عند لحظة التأسيس، فالله المستعان.
نشر في تركيا بوست
Cemal Karakas: Turkey, Islam and Laicism, p. 29. Aydin, Çakır: Political Islam in Turkey, p. 2. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص336. برنامج تحت المجهر: "العثمانيون الجدد"، قناة الجزيرة، بتاريخ 26 يوليو 2007 Aydin, Çakır: Political Islam in Turkey, p. 2. Aydin, Çakır: Political Islam in Turkey, p. 2. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص323. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص365 وما بعدها. Cemal Karakas: Turkey, Islam and Laicism, p. 29. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص369. برنامج تحت المجهر: "العثمانيون الجدد"، قناة الجزيرة، بتاريخ 26 يوليو 2007 بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص370. http://www.akparti.org.tr/english/akp... بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص312، 337. أبرزهم: مجاهد أرسلان، عمر تشاليك، فاروق كوجا، أحمد توبراق، يافوز سليم أراس. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص307. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص307؛ Ömer Taspinar: Turkey’s Middle East Policies, p. 13; Cemal Karakas: Turkey, Islam and Laicism, p. 28. Heinz Kramer: A Changing Turkey, p. 67-8; ; Cemal Karakas: Turkey, Islam and Laicism, p. 20-1. Rabasa, Larrabee: The Rise of Political Islam, p. 52-3. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص308.
Published on May 18, 2016 15:15
May 14, 2016
موجز قصة النكبة
تعد قصة إنشاء إسرائيل من أهم القصص التي يجب أن تدرسها الحركات الإسلامية وكافة الساعين إلى التغيير، كما ينبغي أن يتعلمها أبناء المدارس وأبناء جيل الصحوة، ذلك أنها نموذج لنجاح باهر في تأسيس دولة من العدم، ثم إنها ليست أي دولة بل هي الدولة التي ينعقد على وجودها وفنائها مصير العالم، إنها جوهر الصراع الحضاري العالمي، كما يقول د. جمال حمدان في "استراتيجية الاستعمار والتحرير".
تبدأ القصة حين نشر هرتزل كتابه "الدولة اليهودية" (1896م)، وكان في التاسعة والثلاثين من عمره، وقد تمتع بصبر وعزيمة وذكاء يثير الإعجاب وإن كرهنا، واستطاع أن يسوِّق للغرب حلا للمشكلة اليهودية المزمنة بأن يجعلوا منهم قاعدة استعمارية غربية متقدمة في الشرق. في العالم التالي كان هرتزل يحول كتابه إلى برنامج عمل في اجتماع بازل السويسرية (1897م)، ويناقش مسائل السياسة والأموال والكوادر البشرية.
لم يتوقف رغم فشله مع الدولة العثمانية والألمان، ولم يتوقف عمله رغم موته المبكر (1904) وهو في الرابعة والأربعين من عمره، فقد ورثه من لا يقل عنه كفاءة ودأبا وذكاءا: حاييم وايزمان، عالم الكيمياء سابقا، وزعيم الصهيونية الثاني والأهم على الإطلاق.
صرح رئيس الوزراء البريطاني كامبل (1907م) بضرورة إنشاء كيان غريب في منطقة شرق المتوسط وعلى مقربة من قناة السويس يكون مواليا للغرب، في تلك اللحظة التي اقتنع فيها ساسة بريطانيا بمشروع الدولة اليهودية كان وايزمان في فلسطين يبحث عن أراضٍ يمكن شراؤها، ويؤسس شركة "تطوير أراضي فلسطين".
لم يمض عامان على هذه اللحظة إلا وتأسست بذرة الجيش الصهيوني (1909م) كحرس لحماية المستوطنات اليهودية، بعدها بعامين آخرين (1911م) رفع اليهود مطلب الاعتراف باللغة العبرية لغة رسمية.
وصل الاختراق الصهيوني إلى درجة وزير في الحكومة البريطانية، ذلك هو هربرت صموئيل المؤسس الحقيقي لإسرائيل، وكان من الذكاء والفهم بحيث رفع مذكرة للحكومة (1915م) يقول فيها بأن الوقت غير مناسب لإنشاء وطن يهودي في فلسطين، ولا بد من احتلال بريطاني يمهد الأوضاع ويهيئ الأرض لهذا المشروع!
وبالفعل، انتهت الحرب العالمية الأولى، واحتلت بريطانيا فلسطين (1917م)، ودخل الجيش البريطاني القدس وضمن صفوفه أول ميليشيا يهودية مدربة على يد الإنجليز، وساعتها زار حاييم وايزمان القدس، لا باعتباره مستثمرا كما في أول مرة، بل باعتباره زعيم المشروع الذي يجري تأسيسه.
لم يكن المشروع ليتم لولا غفلة العرب وسذاجة وخيانة حكامهم، فقد أغرى الإنجليز فيصل بن الشريف حسين ليوافق على قيام دولة يهودية في فلسطين، وقد وافق "الثائر" الذي كان يرجو مساعدة بريطانيا في حركة استقلال العرب عن العثمانيين وتنصيب أبيه خليفة (1919م)!
منذ نزلت الحركة الصهونية إلى فلسطين في ظل الاحتلال البريطاني أنشأت نواة جهازها الاستخباري (1919م) ليجمع المعلومات المفصلة ويرسم خريطة واضحة عن: مدى القبول الشعبي بالمشروع الصهيوني، خريطة الأراضي الفارغة، خريطة السكان، الأراضي التي يسهل شراؤها، السكان الذين يُتوقع منهم المقاومة. فصار لها الآن: جهاز أمني، وجهاز عسكري.. وبقي الجهاز السياسي!
حينئذ نصبت بريطانيا الصهيوني هربرت صموئيل حاكما بريطانيا على فلسطين (1920م) لينفذ بنفسه ما كان قد اقترحه قبل خمس سنوات من تهيئة الأرض عبر البريطانيين للإنشاء الدولة اليهودية، وقد فعل هربرت صموئيل ما يجعله مؤسس إسرائيل الحقيقي؛ ذلك أنه بخلاف تدفق الهجرة اليهودية: سَمَحَ لليهود بالتسلح وبناء جيش منفصل، وسمح لهم بنظام تعليمي منفصل، وأقرَّ العبرية كلغة رسمية، واستولى لنفسه على كل الأراضي المشاع وما يؤول إلى الحاكم ثم منحه اليهود بخلاف مائة قانون أصدرها تسهل تسريب الأراضي لليهود.
وبينما هربرت صموئيل يقيم الدولة اليهودية في فلسطين، يعمل حاييم وايزمان على مستوى السياسة، مستعينا بآل روتشيلد على مستوى الاقتصاد والتمويل، وهكذا جرى توزيع الأدوار والتغطي بالقوة البريطانية العظمى في وقتها.
بعد خمس سنوات (1925م) تضاعف عدد اليهود، ومستوطناتهم، وبدأت تظهر مؤسساتهم وأجهزتهم الإدارية المنفصلة: استقلال ذاتي لتل أبيب، نقابة عمال بزعامة بن جوريون، احتفال مهيب بإنشاء الجامعة العبرية حضره: لويد جورج (رئيس الوزراء البريطاني) وألنبي (الحاكم العسكري البريطاني) وبلفور، وتشرشل، وحاييم وايزمان، وهربرت صموئيل.
تجدر الإشارة إلى أن اليهود استعملوا النداء الديني والخطاب التوراتي بشكل أساسي، بما في ذلك العلماني منهم، وقد بُذِلت مجهودات عظيمة في إعادة بعث واستعمال اللغة العبرية الميتة لتكون لغة الدولة الجديدة، وبهذا حافظ اليهود على مدد دائم وألهبوا طاقات كامنة وخاطبوا جماهير اليهود حول العالم بما يستثير إمكاناتهم.
في كل انتفاضة شعبية كان السلاح البريطاني يتحرك بعنف لإخماد كل مقاومة، واستعملت أسلحة القتل والاغتيال والاعتقالات والنفي والمحاكمات، مع ما يساند هذا من عمل استخباري، وما يغطي هذا كله من عمل سياسي يثير الفرقة بين الزعامات الفلسطينية ويرصد تدابيرها لإجهاضها.
عند العام (1935م) كانت مصانع الصهيونية تصدر الألماس والأقطان إلى خارج فلسطين، وهو ذات العام الذي استشار فيه عز الدين القسام القيادات الفلسطينية في إشعال ثورة على الإنجليز فكان ردهم أن الشعب لم يتهيأ بعد والوقت غير مناسب وما يزال الأمل قائما في الوصول إلى الحقوق من خلال المحاورة والمفاوضة مع الإنجليز. إلا أن القسام أشعل ثورة وكان هو من شهدائها، وشهدت فلسطين عام (1936) أطول إضراب في تاريخها إذ استمر لستة أشهر ثم انتهى بعد تدخل "الحكام العرب" بالنصيحة والتوصية بوقف الإضراب مع الوعد بالتفاهم مع الإنجليز.
في ذلك الوقت كان الوجود الصهيوني قد صار مستقلا عمليا عن الإنجليز ويملك قراره المستقل، وكان الجهاز الأمني الإسرائيلي قد تطور ليصير له جهاز تنصت في مكتب الحاج أمين الحسيني، وهو بمثابة القائد السياسي للثورة الفلسطينية، فكانت تحركات المقاومة الفلسطينية مكشوفة للصهاينة، وقوبلت الثورة الفلسطينية المشتعلة بكافة أنواع القمع الإنجليزي، وكانت الطريقة المتبعة هي: قتل القادة الميدانيين، فصل القادة السياسيين عما يجري بالأرض من خلال النفي أو تسهيل الهروب من فلسطين، وتجريد الناس من كل أنواع السلاح، فمن وجد في بيته ولو بقية رصاصة فارغة نسفوا بيته. وألقت بريطانيا بثقلها لإنهاء الثورة التي استمرت لثلاث سنوات فدفعت بعشرين ألفا من قواتها تحت قيادة أربعة جنرالات كبار ممن شاركوا في الحرب العالمية الأولى.
في المقابل كان اليهود يزيدون عددا بالهجرة، وعتادا بالإمداد الإنجليزي، وخبرة بالتدريب العسكري، وبلغوا من الفعالية حدَّ أن أسسوا لمنظمات "إسلامية" و"وطنية" تشاغب على المنظمات الإسلامية الوطنية الحقيقية وتثير الفرقة والأزمة، وكان الجهاز الأمني قد تكونت لديه صورة واضحة عن أفراد المنظمات الإسلامية في فلسطين، من منهم يسهل التعامل معه، ومن الذي يمكن شراؤه بالمال، ومن الذي لا حل إلا بالتخلص منه.
في أثناء الثورة شكلت بريطانيا لجنة لدراسة الوضع، كعادتها في تشكيل اللجان بُغية تبريد المقاومة ومطّ فترة المفاوضة لشراء الوقت وقمع الثائرين، وبالرغم من كل ما صنعه اليهود من هجرة وتواجد إلا أن مساحة ما يملكون من الأرض فعليا لم تزد على خمسة بالمائة، تتركز في شمال فلسطين، لكن اللجنة انتهت إلى اقتراح تقسيم الأرض بين العرب واليهود، ومنحت اليهود ثلث فلسطين الشمالي، ومنحت العرب ثلثي فلسطين الجنوبي، وجعلت المنطقة الواصلة بين القدس وحيفا مستعمرة بريطانية!! فكان ذلك مكسبا جديدا لليهود أخذوه بقوة السياسة البريطانية إلا أنهم –وكعادتهم- لم يتوقفوا عنده.
أسفرت سنوات الثورة الثلاث (1936 – 1939) عن استشهاد خمسة آلاف فلسطيني، وجرح أربعة عشر ألفا، بخلاف من اعتقلوا أو من طُردوا أو من اضطروا للهرب، وبهذا تمت تصفية الجيل الذي يمكنه التصدي للعصابات الصهيونية بعد عشر سنوات. أي أن الواقع العملي هو أن النكبة وقعت بإخماد الثورة الفلسطينية في نهاية الثلاثينيات.
وفي نهاية الثلاثينات وقعت أحداث درامية، فباشتعال الحرب العالمية الثانية انضم خمسة عشر ألف يهودي إلى صفوف الحلفاء، فتحصل لهم من الخبرة والتدريب واستعمال السلاح ومعرفة العلوم العسكرية ما لم يكن متحصلا للفلسطينيين بحال، عندئذ تحولت "الهاجانا" إلى جيش حقيقي، يملك مجموعة من الطائرات. وفي تلك الفترة وبالتوازي مع هذا المجهود العسكري كان المجهود الأمني الاستخباري يعمل على إتماما ملف "القرى" التي يستكمل فيها معلومات واضحة وتفصيلية عن كل قرية فلسطينية من حيث: نوعية الأرض، الحالة الاقتصادية للسكان، الميول السياسية، مدى سهولة أو صعوبة احتلال هذه القرية.
وللحديث بقية، في المقال القادم بإذن الله تعالى.
نشر في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية
تبدأ القصة حين نشر هرتزل كتابه "الدولة اليهودية" (1896م)، وكان في التاسعة والثلاثين من عمره، وقد تمتع بصبر وعزيمة وذكاء يثير الإعجاب وإن كرهنا، واستطاع أن يسوِّق للغرب حلا للمشكلة اليهودية المزمنة بأن يجعلوا منهم قاعدة استعمارية غربية متقدمة في الشرق. في العالم التالي كان هرتزل يحول كتابه إلى برنامج عمل في اجتماع بازل السويسرية (1897م)، ويناقش مسائل السياسة والأموال والكوادر البشرية.
لم يتوقف رغم فشله مع الدولة العثمانية والألمان، ولم يتوقف عمله رغم موته المبكر (1904) وهو في الرابعة والأربعين من عمره، فقد ورثه من لا يقل عنه كفاءة ودأبا وذكاءا: حاييم وايزمان، عالم الكيمياء سابقا، وزعيم الصهيونية الثاني والأهم على الإطلاق.
صرح رئيس الوزراء البريطاني كامبل (1907م) بضرورة إنشاء كيان غريب في منطقة شرق المتوسط وعلى مقربة من قناة السويس يكون مواليا للغرب، في تلك اللحظة التي اقتنع فيها ساسة بريطانيا بمشروع الدولة اليهودية كان وايزمان في فلسطين يبحث عن أراضٍ يمكن شراؤها، ويؤسس شركة "تطوير أراضي فلسطين".
لم يمض عامان على هذه اللحظة إلا وتأسست بذرة الجيش الصهيوني (1909م) كحرس لحماية المستوطنات اليهودية، بعدها بعامين آخرين (1911م) رفع اليهود مطلب الاعتراف باللغة العبرية لغة رسمية.
وصل الاختراق الصهيوني إلى درجة وزير في الحكومة البريطانية، ذلك هو هربرت صموئيل المؤسس الحقيقي لإسرائيل، وكان من الذكاء والفهم بحيث رفع مذكرة للحكومة (1915م) يقول فيها بأن الوقت غير مناسب لإنشاء وطن يهودي في فلسطين، ولا بد من احتلال بريطاني يمهد الأوضاع ويهيئ الأرض لهذا المشروع!
وبالفعل، انتهت الحرب العالمية الأولى، واحتلت بريطانيا فلسطين (1917م)، ودخل الجيش البريطاني القدس وضمن صفوفه أول ميليشيا يهودية مدربة على يد الإنجليز، وساعتها زار حاييم وايزمان القدس، لا باعتباره مستثمرا كما في أول مرة، بل باعتباره زعيم المشروع الذي يجري تأسيسه.
لم يكن المشروع ليتم لولا غفلة العرب وسذاجة وخيانة حكامهم، فقد أغرى الإنجليز فيصل بن الشريف حسين ليوافق على قيام دولة يهودية في فلسطين، وقد وافق "الثائر" الذي كان يرجو مساعدة بريطانيا في حركة استقلال العرب عن العثمانيين وتنصيب أبيه خليفة (1919م)!
منذ نزلت الحركة الصهونية إلى فلسطين في ظل الاحتلال البريطاني أنشأت نواة جهازها الاستخباري (1919م) ليجمع المعلومات المفصلة ويرسم خريطة واضحة عن: مدى القبول الشعبي بالمشروع الصهيوني، خريطة الأراضي الفارغة، خريطة السكان، الأراضي التي يسهل شراؤها، السكان الذين يُتوقع منهم المقاومة. فصار لها الآن: جهاز أمني، وجهاز عسكري.. وبقي الجهاز السياسي!
حينئذ نصبت بريطانيا الصهيوني هربرت صموئيل حاكما بريطانيا على فلسطين (1920م) لينفذ بنفسه ما كان قد اقترحه قبل خمس سنوات من تهيئة الأرض عبر البريطانيين للإنشاء الدولة اليهودية، وقد فعل هربرت صموئيل ما يجعله مؤسس إسرائيل الحقيقي؛ ذلك أنه بخلاف تدفق الهجرة اليهودية: سَمَحَ لليهود بالتسلح وبناء جيش منفصل، وسمح لهم بنظام تعليمي منفصل، وأقرَّ العبرية كلغة رسمية، واستولى لنفسه على كل الأراضي المشاع وما يؤول إلى الحاكم ثم منحه اليهود بخلاف مائة قانون أصدرها تسهل تسريب الأراضي لليهود.
وبينما هربرت صموئيل يقيم الدولة اليهودية في فلسطين، يعمل حاييم وايزمان على مستوى السياسة، مستعينا بآل روتشيلد على مستوى الاقتصاد والتمويل، وهكذا جرى توزيع الأدوار والتغطي بالقوة البريطانية العظمى في وقتها.
بعد خمس سنوات (1925م) تضاعف عدد اليهود، ومستوطناتهم، وبدأت تظهر مؤسساتهم وأجهزتهم الإدارية المنفصلة: استقلال ذاتي لتل أبيب، نقابة عمال بزعامة بن جوريون، احتفال مهيب بإنشاء الجامعة العبرية حضره: لويد جورج (رئيس الوزراء البريطاني) وألنبي (الحاكم العسكري البريطاني) وبلفور، وتشرشل، وحاييم وايزمان، وهربرت صموئيل.
تجدر الإشارة إلى أن اليهود استعملوا النداء الديني والخطاب التوراتي بشكل أساسي، بما في ذلك العلماني منهم، وقد بُذِلت مجهودات عظيمة في إعادة بعث واستعمال اللغة العبرية الميتة لتكون لغة الدولة الجديدة، وبهذا حافظ اليهود على مدد دائم وألهبوا طاقات كامنة وخاطبوا جماهير اليهود حول العالم بما يستثير إمكاناتهم.
في كل انتفاضة شعبية كان السلاح البريطاني يتحرك بعنف لإخماد كل مقاومة، واستعملت أسلحة القتل والاغتيال والاعتقالات والنفي والمحاكمات، مع ما يساند هذا من عمل استخباري، وما يغطي هذا كله من عمل سياسي يثير الفرقة بين الزعامات الفلسطينية ويرصد تدابيرها لإجهاضها.
عند العام (1935م) كانت مصانع الصهيونية تصدر الألماس والأقطان إلى خارج فلسطين، وهو ذات العام الذي استشار فيه عز الدين القسام القيادات الفلسطينية في إشعال ثورة على الإنجليز فكان ردهم أن الشعب لم يتهيأ بعد والوقت غير مناسب وما يزال الأمل قائما في الوصول إلى الحقوق من خلال المحاورة والمفاوضة مع الإنجليز. إلا أن القسام أشعل ثورة وكان هو من شهدائها، وشهدت فلسطين عام (1936) أطول إضراب في تاريخها إذ استمر لستة أشهر ثم انتهى بعد تدخل "الحكام العرب" بالنصيحة والتوصية بوقف الإضراب مع الوعد بالتفاهم مع الإنجليز.
في ذلك الوقت كان الوجود الصهيوني قد صار مستقلا عمليا عن الإنجليز ويملك قراره المستقل، وكان الجهاز الأمني الإسرائيلي قد تطور ليصير له جهاز تنصت في مكتب الحاج أمين الحسيني، وهو بمثابة القائد السياسي للثورة الفلسطينية، فكانت تحركات المقاومة الفلسطينية مكشوفة للصهاينة، وقوبلت الثورة الفلسطينية المشتعلة بكافة أنواع القمع الإنجليزي، وكانت الطريقة المتبعة هي: قتل القادة الميدانيين، فصل القادة السياسيين عما يجري بالأرض من خلال النفي أو تسهيل الهروب من فلسطين، وتجريد الناس من كل أنواع السلاح، فمن وجد في بيته ولو بقية رصاصة فارغة نسفوا بيته. وألقت بريطانيا بثقلها لإنهاء الثورة التي استمرت لثلاث سنوات فدفعت بعشرين ألفا من قواتها تحت قيادة أربعة جنرالات كبار ممن شاركوا في الحرب العالمية الأولى.
في المقابل كان اليهود يزيدون عددا بالهجرة، وعتادا بالإمداد الإنجليزي، وخبرة بالتدريب العسكري، وبلغوا من الفعالية حدَّ أن أسسوا لمنظمات "إسلامية" و"وطنية" تشاغب على المنظمات الإسلامية الوطنية الحقيقية وتثير الفرقة والأزمة، وكان الجهاز الأمني قد تكونت لديه صورة واضحة عن أفراد المنظمات الإسلامية في فلسطين، من منهم يسهل التعامل معه، ومن الذي يمكن شراؤه بالمال، ومن الذي لا حل إلا بالتخلص منه.
في أثناء الثورة شكلت بريطانيا لجنة لدراسة الوضع، كعادتها في تشكيل اللجان بُغية تبريد المقاومة ومطّ فترة المفاوضة لشراء الوقت وقمع الثائرين، وبالرغم من كل ما صنعه اليهود من هجرة وتواجد إلا أن مساحة ما يملكون من الأرض فعليا لم تزد على خمسة بالمائة، تتركز في شمال فلسطين، لكن اللجنة انتهت إلى اقتراح تقسيم الأرض بين العرب واليهود، ومنحت اليهود ثلث فلسطين الشمالي، ومنحت العرب ثلثي فلسطين الجنوبي، وجعلت المنطقة الواصلة بين القدس وحيفا مستعمرة بريطانية!! فكان ذلك مكسبا جديدا لليهود أخذوه بقوة السياسة البريطانية إلا أنهم –وكعادتهم- لم يتوقفوا عنده.
أسفرت سنوات الثورة الثلاث (1936 – 1939) عن استشهاد خمسة آلاف فلسطيني، وجرح أربعة عشر ألفا، بخلاف من اعتقلوا أو من طُردوا أو من اضطروا للهرب، وبهذا تمت تصفية الجيل الذي يمكنه التصدي للعصابات الصهيونية بعد عشر سنوات. أي أن الواقع العملي هو أن النكبة وقعت بإخماد الثورة الفلسطينية في نهاية الثلاثينيات.
وفي نهاية الثلاثينات وقعت أحداث درامية، فباشتعال الحرب العالمية الثانية انضم خمسة عشر ألف يهودي إلى صفوف الحلفاء، فتحصل لهم من الخبرة والتدريب واستعمال السلاح ومعرفة العلوم العسكرية ما لم يكن متحصلا للفلسطينيين بحال، عندئذ تحولت "الهاجانا" إلى جيش حقيقي، يملك مجموعة من الطائرات. وفي تلك الفترة وبالتوازي مع هذا المجهود العسكري كان المجهود الأمني الاستخباري يعمل على إتماما ملف "القرى" التي يستكمل فيها معلومات واضحة وتفصيلية عن كل قرية فلسطينية من حيث: نوعية الأرض، الحالة الاقتصادية للسكان، الميول السياسية، مدى سهولة أو صعوبة احتلال هذه القرية.
وللحديث بقية، في المقال القادم بإذن الله تعالى.
نشر في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية
Published on May 14, 2016 14:55
May 12, 2016
كيف اتفقت الوثنية والمسيحية والعلمانية على افتراس البيئة
* هذا المقال نموذج تطبيقي لمسألة "البحث عن الأصول والكليات" في السياق الحضاري
تبدو قضية البيئة للوهلة الأولى وكأنها بعيدة عن سياق الأفكار الغربية، لكن ما إن يتعمق المرء قليلا في النظر إلى هذه القضية إلا ويبدو له أثر الفكر الغربي فيها واضحا، وكيف أن أفكار العصور المختلفة التي تمثل انقلابا على بعضها في أمور كثيرة تختزن في عمق باطنها فكرة واحدة هي "السيطرة" و"التحكم" و"الاستعمال" -بالمعنى المادي السلبي- لكل ما ليس بغربي.
يستمد الغرب المعاصر أفكاره من ثلاثة روافد؛ رافد قديم: وهو الفلسفة اليونانية، ورافد وسيط: وهو المسيحية، ورافد حديث: وهو أفكار عصر التنوير والحداثة.
1. فأما الفلسفة اليونانية فقد أسست لعلاقة منقطعة بين الإله وبين الكون والإنسان، فالإله عند أرسطو خلق الكون وتركه لأنه أعظم من أن يفكر في شيء أقل منه (!)، كصانع الساعة، أودع فيها القوانين التي تسيرها ثم لا يراعيها. كما أسست لطبقية وعنصرية عنيفة بين البشر أنفسهم؛ فيرى أفلاطون وأرسطو أن الناس ثلاث طبقات؛ الطائفة الذهبية: وهم الفلاسفة الحكماء على رأس الهرم، ثم الطائفة الحديدية: وهم المحاربون والصناع الذين خُلِقوا للطاعة العمياء، ثم العبيد وهم البهائم العاقلة، ورأى أفلاطون أنه لا يجوز لأحد في طبقة ما أن يطمح إلى غيرها وألزمه بقبول حكم الطبيعة عليه ليكون سعيدا· بعض الرعايا ممن ليسوا رومانا بالسلالة ليست لهم حقوق الرومان، فهم كالعبيد يعملون لأجل الرومان ولتشبع بطونهم.
· إن العبيد لا يعاملون معاملة الآدميين.
· ليست للمرأة شخصية مستقلة بل هي في حكم المملوكة للرجل أبا كان أم زوجا.
وبعد هذا يُعد من السذاجة أن نسأل عن الموقف من الطبيعة والبيئة والنبات والكائنات!
على أن أخطر ما أسست له أساطير اليونان، كانت العلاقة بين الإله والإنسان، فهما في صراع مستمر؛ الإله يريد الاحتفاظ بالعلم ليحتفظ بهيمنته على البشر، والإنسان يريد العلم ليتحرر من تحكم الإله ويتأله بنفسه ويتحكم في الكون، فأي اكتشاف هو خصم من الإله وإضافة إلى الإنسان حتى تأتي اللحظة المنشودة: لحظة إزاحة الإله وتنصيب الإنسان إلهاولقد كان تاريخ الحضارات الغربية القديمة هو التطبيق العملي لهذا الوجه الفكري الفلسفي، فلقد استبدوا بالشعوب ونهبوا الثروات وافترسوا ما أمكنهم من بشر أو موارد.
2. وأما المسيحية فقد اختلطت بالوثنية حتى كان أثر الوثنية في المسيحية أكبر من أثر المسيحية فيها، وظهر هذا في النصوص المحرفة التي صارت تنادي بالإخضاع، وتجعل العلاقة بين الإنسان والطبيعة علاقة سيطرة وقهر وتحكم، فمن ذلك مثلا:
§ "فَخَلَق الله الإنسان على صورته، وعلى صورة الله خلقه ذكرًا وأنثى، خلقهم وباركهم وقال لهم: انموا واكثروا واملئوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على أسماك البحر وطيور السماء، وكل حيوان يدب على الأرض"§ "اذهب، واضرب عماليق، وحَرِّموا كل ما له، ولا تعف عنهم، بل اقتل رجلا وامراة، طفلا ورضيعا، بقرا وغنما، جملا وحمارا"§ ومثله ما جاء في سفر يشوع: "وحرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة، من طفل وشيخ، حتى البقر والغنم والحمير، بحد السيف"وقد نتج عن مثل هذه النصوص "المقدسة" كثيرٌ من التفسيرات والمواقف العملية، ففي منتصف القرن التاسع عشر مَنَع البابا بيوس التاسع إنشاء فرع لجميعة الرفق بالحيوان في الفاتيكان لأن "الحيوانات مجردة من الروح، ومن ثَمَّ لا تصلح لأن تكون موضعًا لاعتبارات أخلاقية"، وفي عام 1973م، قال رئيس أساقفة لوس أنجلوس: "من الأفضل الاحتفاظ بالرأي القائل بأن الطبيعة عدو للإنسان، فهي القوة الغريبة عنه، والتي ينبغي له أن يقهرها ويروضها بعزيمته"لهذه النصوص والتفسيرات والمواقف نجد كثيرا من علماء البيئة -لا سيما الملحدين منهم- يرون المشكلة البيئية كامنة أصلا في الدين الذي يعطي الإنسان حق السيطرة والقهر على ما حوله، إلى درجة الترحيب بالتدمير البيئي3. وأما أقوى الروافد وأوسعها تأثيرا في مسألة البيئة فهو فلسفات عصر التنوير والحداثة، وفي هذه الحقبة ظهرت مشكلة البيئة وتفاقمت حتى بلغت حد الكارثة، وحتى الآن ما تزال كل مجهودات إنقاذ البيئة تتحطم على صخرة هذه الأفكار وما أنتجته من سياسات وأنظمة.
كان من المحتم أن يقع الصدام بين الكنيسة والعلم لأكثر من سبب، منها أن بعض الاتجاهات المسيحية نظرت إلى العلم باحتقار انطلاقا من قول بولس "ألم يصف الربُّ المعرفة الدنيويَّة بالغباوة؟"ثمة محطات ثلاث يمكن التقاطها في هذا السياق؛ الأولى: اكتشاف نيوتن قوانين الحركة والجاذبية، وبدلا من أن يكون رد الفعل "سبحان الله خالق هذه القوانين" طرحت أجواء المعركة مع الكنيسة ردة فعل معاكسة: الكون يسير وفق قوانين حتمية ولا وجود لإله يسيِّره ويرعاه، الثانية: طرح داروين نظرية النشوء والارتقاء، فكان كأنما ألقى بحجر ينتظره الجميع ليعلن انتهاء الإله بشكل كامل وأن الكائنات تستطيع التكيف ويمكنها أن ترتقي وتغير من تشكلها وفق حاجتهاونحن حين نقرأ نصوص تلك الفترة نشعر أن برومثيوس قد عاد إلى الحياة بعد قرون، هذا إيريش فوندانكين يقول بصراحة: "السمة المشتركة لكل الأديان هي أنها وعدت بتقديم العون والخلاص للجنس البشري، فلماذا لم تفِ تلك الآلهة بوعودها؟ إن عالم الأفكار الذي نشأ وتضخم على مدى ألف سنة في طريقه إلى الانهيار، حيث إن سنوات قليلة من البحث العلمي الدقيق قد أدت إلى تقويض ذلك الصرح الفكري"وحين تخلت أوروبا عن المسيحية اعتنقت المادية وأزاحت كل "ما وراء الطبيعة"، فكان طبيعيا أن ينفجر النهر الفياض من الشهوات واللذائذ، وأن يعب المرء من الحياة ما استطاع بكل ما استطاع، فخلاصة الحياة في ظلال المادية تلخصها عبارة ألبير كامي -فيلسوف العدمية الشهير- القائلة: "كل شيء جائز طالما أن الله غير موجود وأن الإنسان يموت"ومع نمو الرأسمالية تحولت قيم الاستهلاك نفسها إلى "فلسفة مطلوبة؛ إذ إن تكاثر الإنتاج يقتضي ويريد تكاثرا في الاستهلاك، فيسعى أصحاب الإنتاج أنفسهم إلى خلق نوعيات جديدة للاحتياج عبر الدعاية والإعلان والتطوير المستمر للمنتجات، والبحث عن أسواق جديدة، وتقصير عمر المنتج ليستهلك سريعا؛ ولهذا فإن السيارات الحديثة لا تتمتع بأعمار السيارات القديمة، وكذلك البنايات الحديثة لا تعيش أبدا كما عاشت البنايات الأقدم منها"، وهذا ما يسميه جان ماري بيليت -أحد علماء البيئة البارزين- بـ "مجتمع النفايات"، ويرمز لها بنهر "له منبع وهو الاقتصاد الذي يضخ عددا رهيبا من السلع والمنتجات لتلبية حاجات الاستهلاك المتزايدة، وله أيضا مصب وهو تراكم النفايات بعد انتهاء الاستهلاك، وهذا ما ينتج ثلاث مشكلات: مشكلة الطاقة، ومشكلة الموارد الأولية، ومشكلة تلوث البيئة"وقصة الغرب في عصره الحديث تكاد تكون واحدة، منذ إسبانيا التي كانت أول المتمتعين بثروات العالم الجديدوالأخطر من "الأفعال" الأمريكية "سياستها وفلسفتها"، ففي مايو 1992م جرت لأول مرة عملية "التجارة بالتلوث"، وذلك أن وكالة "تينيسي فالي" دفعت إلى شركة للطاقة في ولاية ويسكونسن، من أجل منحها "الحق" بقذف عدة أطنان من ثاني أكسيد الكبريت في الجو، فخفضت ويسكونين من تلوثها لموازنة تلوث تينيسي، سامحة بذلك للوكالة بتجاوز الحدود العليا للتلوث المحددة بواسطة القانونوهكذا كانت البيئة فريسة على مائدة الروافد الثلاثة المغذية للفكر الغربي منذ الفلسفة اليونانية وعصور اليونان والرومان، مرورا بهيمنة المسيحية وعصور الملوك والإقطاع، وحتى فلسفات التنوير والحداثة في عصور القوميات والاستعمار والنظام العالمي. تختلف الظواهر ويبقى العمق البعيد الغائر واحدا لكنه يغير ثوبه.
نشر في ساسة بوست
ول ديورانت: قصة الفلسفة ص23 وما بعدها، ماريا لويزا برنيري: المدينة الفاضلة عبر التاريخ ص26 وما بعدها، السيد محمد بدوي: الأخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتماع ص52. مونتسكيو: روح الشرائع 2/ 146، برتراند رسل: حكمة الغرب 1/ 100، 143، 157، أرنولد توينبي: مختصر دراسة التاريخ 1/ 93. محمد قطب: واقعنا المعاصر ص89. سفر التكوين 1/27. سفر صموئيل الأول 15/3. سفر يشوع 6/21. إيان ج. سيمونز: البيئة والإنسان عبر العصور ص226. يقول النص: "وستظهر علامات في الشمس والقمر والنجوم، وينال الأمم كرب في الأرض ورهبة من عجيج البحر وأمواجه. وستزهق نفوس الناس من الخوف، ومن توقع ما ينزل في العالم؛ لأن أجرام السماء تتزعزع، وحينئذ يرى الناس ابن الإنسان آتيًا في الغمام في تمام العزة والجلال. وإذا أخذت هذه الأمور تحدث فانتصبوا قائمين وارفعوا رءوسكم؛ لأن افتداءكم قد قرب". إنجيل لوقا 21/25-32. انظر: جعفر هادي حسن: المسيحيون الصهيونيون ونظرتهم إلى العالم، مجلة الحوار المتمدن، 3/11/2007م، ومقال بعنوان "ليس هناك غد" مترجم عن دورية ستار تريبيون ومنشور بموقع "إسلام ديلي" بتاريخ 30/1/2005م. انظر: مايكل زيمر مان: الفلسفة البيئية ص19، 20، إيان ج. سيمونز: البيئة والإنسان عبر العصور ص225. زيجريد هونكه: شمس الله تسطع على الغرب ص369. ول ديورانت: قصة الحضارة 27/138، 139. بتصرف. في نفس الوقت كان مندل يبحث في علم الوراثة، ولم يخرج بشيء أكثر من إمكانية تحسن السلالات عن طريق التهجيبن، ورغم أن إثباتات مندل أقوى كثيرا من نظرية دارون، إلا أن الأجواء الطموحة إلى التخلص من الدين وإلهه طارت بأفكار دارون دون مندل. إيريش فون دانكين: عربات الآلهة ص6. علي عزت بيجوفيتش: الإسلام بين الشرق والغرب ص139. د. عبد الوهاب المسيري: العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة 2/ 120. جارودي: وعود الإسلام ص20. جان ماري بيلت: عودة الوفاق بين الإنسان والطبيعة ص48، 50، 56، 59. انظر: جوستاف لوبون: حضارة العرب ص584، 585. انظر: ول ديورانت: قصة الحضارة 32/128، وتشيع صورة لندن البائسة الغارقة في الدخان والروائح الكريهة في الروايات الإنجليزية المكتوبة في هذه الفترة. جريج بالاست: أفضل ديمقراطية يستطيع المال شراءها ص222، 223. جريج بالاست: أفضل ديمقراطية يستطيع المال شراءها ص223 وما بعدها.
تبدو قضية البيئة للوهلة الأولى وكأنها بعيدة عن سياق الأفكار الغربية، لكن ما إن يتعمق المرء قليلا في النظر إلى هذه القضية إلا ويبدو له أثر الفكر الغربي فيها واضحا، وكيف أن أفكار العصور المختلفة التي تمثل انقلابا على بعضها في أمور كثيرة تختزن في عمق باطنها فكرة واحدة هي "السيطرة" و"التحكم" و"الاستعمال" -بالمعنى المادي السلبي- لكل ما ليس بغربي.
يستمد الغرب المعاصر أفكاره من ثلاثة روافد؛ رافد قديم: وهو الفلسفة اليونانية، ورافد وسيط: وهو المسيحية، ورافد حديث: وهو أفكار عصر التنوير والحداثة.
1. فأما الفلسفة اليونانية فقد أسست لعلاقة منقطعة بين الإله وبين الكون والإنسان، فالإله عند أرسطو خلق الكون وتركه لأنه أعظم من أن يفكر في شيء أقل منه (!)، كصانع الساعة، أودع فيها القوانين التي تسيرها ثم لا يراعيها. كما أسست لطبقية وعنصرية عنيفة بين البشر أنفسهم؛ فيرى أفلاطون وأرسطو أن الناس ثلاث طبقات؛ الطائفة الذهبية: وهم الفلاسفة الحكماء على رأس الهرم، ثم الطائفة الحديدية: وهم المحاربون والصناع الذين خُلِقوا للطاعة العمياء، ثم العبيد وهم البهائم العاقلة، ورأى أفلاطون أنه لا يجوز لأحد في طبقة ما أن يطمح إلى غيرها وألزمه بقبول حكم الطبيعة عليه ليكون سعيدا· بعض الرعايا ممن ليسوا رومانا بالسلالة ليست لهم حقوق الرومان، فهم كالعبيد يعملون لأجل الرومان ولتشبع بطونهم.
· إن العبيد لا يعاملون معاملة الآدميين.
· ليست للمرأة شخصية مستقلة بل هي في حكم المملوكة للرجل أبا كان أم زوجا.
وبعد هذا يُعد من السذاجة أن نسأل عن الموقف من الطبيعة والبيئة والنبات والكائنات!
على أن أخطر ما أسست له أساطير اليونان، كانت العلاقة بين الإله والإنسان، فهما في صراع مستمر؛ الإله يريد الاحتفاظ بالعلم ليحتفظ بهيمنته على البشر، والإنسان يريد العلم ليتحرر من تحكم الإله ويتأله بنفسه ويتحكم في الكون، فأي اكتشاف هو خصم من الإله وإضافة إلى الإنسان حتى تأتي اللحظة المنشودة: لحظة إزاحة الإله وتنصيب الإنسان إلهاولقد كان تاريخ الحضارات الغربية القديمة هو التطبيق العملي لهذا الوجه الفكري الفلسفي، فلقد استبدوا بالشعوب ونهبوا الثروات وافترسوا ما أمكنهم من بشر أو موارد.
2. وأما المسيحية فقد اختلطت بالوثنية حتى كان أثر الوثنية في المسيحية أكبر من أثر المسيحية فيها، وظهر هذا في النصوص المحرفة التي صارت تنادي بالإخضاع، وتجعل العلاقة بين الإنسان والطبيعة علاقة سيطرة وقهر وتحكم، فمن ذلك مثلا:
§ "فَخَلَق الله الإنسان على صورته، وعلى صورة الله خلقه ذكرًا وأنثى، خلقهم وباركهم وقال لهم: انموا واكثروا واملئوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على أسماك البحر وطيور السماء، وكل حيوان يدب على الأرض"§ "اذهب، واضرب عماليق، وحَرِّموا كل ما له، ولا تعف عنهم، بل اقتل رجلا وامراة، طفلا ورضيعا، بقرا وغنما، جملا وحمارا"§ ومثله ما جاء في سفر يشوع: "وحرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة، من طفل وشيخ، حتى البقر والغنم والحمير، بحد السيف"وقد نتج عن مثل هذه النصوص "المقدسة" كثيرٌ من التفسيرات والمواقف العملية، ففي منتصف القرن التاسع عشر مَنَع البابا بيوس التاسع إنشاء فرع لجميعة الرفق بالحيوان في الفاتيكان لأن "الحيوانات مجردة من الروح، ومن ثَمَّ لا تصلح لأن تكون موضعًا لاعتبارات أخلاقية"، وفي عام 1973م، قال رئيس أساقفة لوس أنجلوس: "من الأفضل الاحتفاظ بالرأي القائل بأن الطبيعة عدو للإنسان، فهي القوة الغريبة عنه، والتي ينبغي له أن يقهرها ويروضها بعزيمته"لهذه النصوص والتفسيرات والمواقف نجد كثيرا من علماء البيئة -لا سيما الملحدين منهم- يرون المشكلة البيئية كامنة أصلا في الدين الذي يعطي الإنسان حق السيطرة والقهر على ما حوله، إلى درجة الترحيب بالتدمير البيئي3. وأما أقوى الروافد وأوسعها تأثيرا في مسألة البيئة فهو فلسفات عصر التنوير والحداثة، وفي هذه الحقبة ظهرت مشكلة البيئة وتفاقمت حتى بلغت حد الكارثة، وحتى الآن ما تزال كل مجهودات إنقاذ البيئة تتحطم على صخرة هذه الأفكار وما أنتجته من سياسات وأنظمة.
كان من المحتم أن يقع الصدام بين الكنيسة والعلم لأكثر من سبب، منها أن بعض الاتجاهات المسيحية نظرت إلى العلم باحتقار انطلاقا من قول بولس "ألم يصف الربُّ المعرفة الدنيويَّة بالغباوة؟"ثمة محطات ثلاث يمكن التقاطها في هذا السياق؛ الأولى: اكتشاف نيوتن قوانين الحركة والجاذبية، وبدلا من أن يكون رد الفعل "سبحان الله خالق هذه القوانين" طرحت أجواء المعركة مع الكنيسة ردة فعل معاكسة: الكون يسير وفق قوانين حتمية ولا وجود لإله يسيِّره ويرعاه، الثانية: طرح داروين نظرية النشوء والارتقاء، فكان كأنما ألقى بحجر ينتظره الجميع ليعلن انتهاء الإله بشكل كامل وأن الكائنات تستطيع التكيف ويمكنها أن ترتقي وتغير من تشكلها وفق حاجتهاونحن حين نقرأ نصوص تلك الفترة نشعر أن برومثيوس قد عاد إلى الحياة بعد قرون، هذا إيريش فوندانكين يقول بصراحة: "السمة المشتركة لكل الأديان هي أنها وعدت بتقديم العون والخلاص للجنس البشري، فلماذا لم تفِ تلك الآلهة بوعودها؟ إن عالم الأفكار الذي نشأ وتضخم على مدى ألف سنة في طريقه إلى الانهيار، حيث إن سنوات قليلة من البحث العلمي الدقيق قد أدت إلى تقويض ذلك الصرح الفكري"وحين تخلت أوروبا عن المسيحية اعتنقت المادية وأزاحت كل "ما وراء الطبيعة"، فكان طبيعيا أن ينفجر النهر الفياض من الشهوات واللذائذ، وأن يعب المرء من الحياة ما استطاع بكل ما استطاع، فخلاصة الحياة في ظلال المادية تلخصها عبارة ألبير كامي -فيلسوف العدمية الشهير- القائلة: "كل شيء جائز طالما أن الله غير موجود وأن الإنسان يموت"ومع نمو الرأسمالية تحولت قيم الاستهلاك نفسها إلى "فلسفة مطلوبة؛ إذ إن تكاثر الإنتاج يقتضي ويريد تكاثرا في الاستهلاك، فيسعى أصحاب الإنتاج أنفسهم إلى خلق نوعيات جديدة للاحتياج عبر الدعاية والإعلان والتطوير المستمر للمنتجات، والبحث عن أسواق جديدة، وتقصير عمر المنتج ليستهلك سريعا؛ ولهذا فإن السيارات الحديثة لا تتمتع بأعمار السيارات القديمة، وكذلك البنايات الحديثة لا تعيش أبدا كما عاشت البنايات الأقدم منها"، وهذا ما يسميه جان ماري بيليت -أحد علماء البيئة البارزين- بـ "مجتمع النفايات"، ويرمز لها بنهر "له منبع وهو الاقتصاد الذي يضخ عددا رهيبا من السلع والمنتجات لتلبية حاجات الاستهلاك المتزايدة، وله أيضا مصب وهو تراكم النفايات بعد انتهاء الاستهلاك، وهذا ما ينتج ثلاث مشكلات: مشكلة الطاقة، ومشكلة الموارد الأولية، ومشكلة تلوث البيئة"وقصة الغرب في عصره الحديث تكاد تكون واحدة، منذ إسبانيا التي كانت أول المتمتعين بثروات العالم الجديدوالأخطر من "الأفعال" الأمريكية "سياستها وفلسفتها"، ففي مايو 1992م جرت لأول مرة عملية "التجارة بالتلوث"، وذلك أن وكالة "تينيسي فالي" دفعت إلى شركة للطاقة في ولاية ويسكونسن، من أجل منحها "الحق" بقذف عدة أطنان من ثاني أكسيد الكبريت في الجو، فخفضت ويسكونين من تلوثها لموازنة تلوث تينيسي، سامحة بذلك للوكالة بتجاوز الحدود العليا للتلوث المحددة بواسطة القانونوهكذا كانت البيئة فريسة على مائدة الروافد الثلاثة المغذية للفكر الغربي منذ الفلسفة اليونانية وعصور اليونان والرومان، مرورا بهيمنة المسيحية وعصور الملوك والإقطاع، وحتى فلسفات التنوير والحداثة في عصور القوميات والاستعمار والنظام العالمي. تختلف الظواهر ويبقى العمق البعيد الغائر واحدا لكنه يغير ثوبه.
نشر في ساسة بوست
ول ديورانت: قصة الفلسفة ص23 وما بعدها، ماريا لويزا برنيري: المدينة الفاضلة عبر التاريخ ص26 وما بعدها، السيد محمد بدوي: الأخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتماع ص52. مونتسكيو: روح الشرائع 2/ 146، برتراند رسل: حكمة الغرب 1/ 100، 143، 157، أرنولد توينبي: مختصر دراسة التاريخ 1/ 93. محمد قطب: واقعنا المعاصر ص89. سفر التكوين 1/27. سفر صموئيل الأول 15/3. سفر يشوع 6/21. إيان ج. سيمونز: البيئة والإنسان عبر العصور ص226. يقول النص: "وستظهر علامات في الشمس والقمر والنجوم، وينال الأمم كرب في الأرض ورهبة من عجيج البحر وأمواجه. وستزهق نفوس الناس من الخوف، ومن توقع ما ينزل في العالم؛ لأن أجرام السماء تتزعزع، وحينئذ يرى الناس ابن الإنسان آتيًا في الغمام في تمام العزة والجلال. وإذا أخذت هذه الأمور تحدث فانتصبوا قائمين وارفعوا رءوسكم؛ لأن افتداءكم قد قرب". إنجيل لوقا 21/25-32. انظر: جعفر هادي حسن: المسيحيون الصهيونيون ونظرتهم إلى العالم، مجلة الحوار المتمدن، 3/11/2007م، ومقال بعنوان "ليس هناك غد" مترجم عن دورية ستار تريبيون ومنشور بموقع "إسلام ديلي" بتاريخ 30/1/2005م. انظر: مايكل زيمر مان: الفلسفة البيئية ص19، 20، إيان ج. سيمونز: البيئة والإنسان عبر العصور ص225. زيجريد هونكه: شمس الله تسطع على الغرب ص369. ول ديورانت: قصة الحضارة 27/138، 139. بتصرف. في نفس الوقت كان مندل يبحث في علم الوراثة، ولم يخرج بشيء أكثر من إمكانية تحسن السلالات عن طريق التهجيبن، ورغم أن إثباتات مندل أقوى كثيرا من نظرية دارون، إلا أن الأجواء الطموحة إلى التخلص من الدين وإلهه طارت بأفكار دارون دون مندل. إيريش فون دانكين: عربات الآلهة ص6. علي عزت بيجوفيتش: الإسلام بين الشرق والغرب ص139. د. عبد الوهاب المسيري: العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة 2/ 120. جارودي: وعود الإسلام ص20. جان ماري بيلت: عودة الوفاق بين الإنسان والطبيعة ص48، 50، 56، 59. انظر: جوستاف لوبون: حضارة العرب ص584، 585. انظر: ول ديورانت: قصة الحضارة 32/128، وتشيع صورة لندن البائسة الغارقة في الدخان والروائح الكريهة في الروايات الإنجليزية المكتوبة في هذه الفترة. جريج بالاست: أفضل ديمقراطية يستطيع المال شراءها ص222، 223. جريج بالاست: أفضل ديمقراطية يستطيع المال شراءها ص223 وما بعدها.
Published on May 12, 2016 22:47
May 10, 2016
الرؤية الفكرية لحزب العدالة والتنمية
وصلنا في استعراضنا لتاريخ السياسة التركية –في المقالات الماضية- إلى لحظة تأسيس حزب العدالة والتنمية، وبعد أن ذكرنا قصة المؤسس أردوغان، وقصة الخلاف بينه وبين أستاذه أربكان، وألقينا نظرة على المؤسسين، ندلف إلى تحديات التأسيس!
كغيره من الأحزاب، واجه حزب العدالة والتنمية تحديات التأسيس: الرؤية الفكرية، الكوادر، البرنامج، الأموال. وكان عليه أن يعبر هذه التحديات في ظل واقع تتنازعه التوجهات؛ إذ هو يحتاج أن يثبت عدم تخليه عن الإسلام داخل بيئة التيار الإسلامي، ويحتاج أن يثبت أنه لم يخرج عن علمانية الجمهورية أمام الدولة العميقة، ويحتاج أن يثبت أنه صورة جديدة من "الإسلام السياسي" الذي يمكن للغرب أن يتفق معه وأن يجربه ويعتمد عليه، وكأنه يقدم "إسلاما جديدا" ملتزما بالثوابت التي تطرحها "الحضارة الغربية". ولم يكن بوسعه تقديم خطاب مزدوج في عصر ثورة الإعلام والاتصالات، فلا مناص حينئذ من خطاب دقيق ومتوازن، ثم من تنازلات وتضحيات ببعض الأطراف عند لحظات فارقة لا بد فيها من الاختيار حين لا ينفع التوازن والبقاء في منطقة رمادية.
بدأت المجموعة المؤسسة بإقامة مركزين للبحوث السياسية والفكرية: الأول مركز مؤسسة دنجه للأبحاث في أنقره والثاني مركز الأبحاث السياسية في اسطنبوللئن كانت الرؤية الفكرية أصعب شيء في تأسيس الأحزاب والجماعات والكيانات السياسية؛ إذ ينبني عليها سائر التوجهات والاختيارات، فلقد كانت في حالة حزب العدالة والتنمية أصعب؛ فالحزب تتنازعه جذوره الإسلامية مع ثوابت الدولة العلمانية التي يحرسها العسكر بقوة السلاح، وهذا كله تحت مظلة وضع دولي يثير حربا على "الإرهاب الإسلامي" بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وهذه الحرب على وشك أن تشتعل عند أطراف الثوب التركي: العراق!
لقد أثار الأمر خلافا بين المؤسسين، لكنهم خلصوا في النهاية إلى هذه الهوية ذات المساحات الرمادية، ولذا فمن أراد رؤيتهم كإسلاميين وَجَدَ في أدبياتهم ما يدعم خطه، ومن أراد رؤيتهم كعلمانيين وجد ما يدعم خطه، ومن أراد إثبات ما في خطابهم من ارتباك وتناقض وجد ما أراد كذلك، ويعلن كثير من الباحثينيبدو أردوغان إسلاميا عثمانيا يطرح نفسه كنقيض للحقبة الجمهورية العلمانية حين يقول في خطاب تأسيس الحزب (14 أغسطس 2001م) "تركيا لنا جميعا. إن تركيا منذ عام 1299م إلى عام 1923 كانت دائما تتولد منا نحن"ولكن يبدو مُنَظِّر الحزب، المفكر التركي أحمد أوزجان، متناقضا حين يقول في مرحلة التأسيس: "تركيا يجب أن تتخطى صراع الهيمنة والسيطرة الموجود بين الكتلة المسالمة والكتلة الكمالية. وعلى إنسان الأناضول أيضا أن يفرض على الساحة كادره الذي يُمَكّنه أن يحوي كلا الطرفين بداخله، والذي يخاطب الشعب بأكمله، وله هويته الإسلامية الخالصة، والذي ينتج ويعلن تجلياته الحقيقية"ومن المفهوم في عالم السياسة الحفاظ على مساحة من الغموض، كما في تصريح لعضو كبير بحزب العدالة والتنمية يقول: ليس المهم هو ما إذا كان الإسلام يؤثر في السياسة، ولكن "كيف" يكون هذا التأثير، فالتفسير الليبرالي للإسلام يؤثر في السياسة على نحو ليبراليلقد تمسك الحزب بإصرار –على مستوى الطرح الفكري- أنه يمكن الجمع بين كل ما يُظَنُّ أنه متناقض كما يقول أردوغان: "أنا حزبي محافظ ديمقراطي، محافظ أسعى للحفاظ على عاداتنا وتقاليدنا وثقافة الأمة التركية، وأسعى لتطبيق ديمقراطية قوية ومتطورة ولا تقل عن الديمقراطيات في العالم"ولئن صَعُب على الكثيرين ابتلاع هذا التوجه وفهمه، فإن الذي كان سهلا وواضحا وثابتا في رؤية الحزب وخطابه هو التخلي عن الخطاب المعادي للغرب الذي تبناه الإسلاميون سابقا، وتبنى خطابا متسقا مع ما يُطرح في المجتمعات الغربيةوما كان واضحا بذات الدرجة أنهم نقيض للاستبداد واعتبروا "ما يفعلونه بمثابة إحياء جديد لكل الأحزاب التي تم غلقها، وبمثابة عودة الفكر الوطني و(عودة لمن قُهِروا) من السياسيين"لقد مثلت هذه الطريقة نمطا جديدا في السياسة التي يتصدرها إسلاميون، ما جعلها مسرحا لابتكار الألفاظ والمصطلحات لدى الباحثين لمحاولة التعبير عن الظاهرة، فوُصِفَت بأنها "سياسة مرتاحة" يمثل الدين فيها إلهاما ثقافيا أكثر منه حضورا فاعلا في أجندة السياسةنشر في تركيا بوست
بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص306. برنامج تحت المجهر: "العثمانيون الجدد"، قناة الجزيرة، بتاريخ 26 يوليو 2007 كثير من الغموض أو الارتباك راجع أيضا إلى خلفيات الباحثين الفكرية، إذ الكثير يفهم الديمقراطية كنقيض للإسلام بغير اعتبار لما أفاض الإسلاميون في شرحه من تفريقهم بينها كفلسفة أو آليات، ونظرياتهم في تطبيق الإسلام في العالم المعاصر. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص327. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص304. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص309. Rabasa, Larrabee: The Rise of Political Islam, p. 54. محمد زاهد جل: التجربة النهضوية التركية ص16. محمد زاهد جل: التجربة النهضوية التركية ص89. برنامج تحت المجهر: "العثمانيون الجدد"، قناة الجزيرة، بث بتاريخ 26/7/2007؛ Rabasa, Larrabee: The Rise of Political Islam, p. 47. حوار مع عبد الله غل، برنامج حوار خاص، قناة الجزيرة، بتاريخ 22/11/2002. برنامج تحت المجهر: "العثمانيون الجدد"، قناة الجزيرة، بتاريخ 26 يوليو 2007 محمد زاهد جل: التجربة النهضوية التركية ص72. Rabasa, Larrabee: The Rise of Political Islam, p. 50; Ümit Cizer: The Justice and Development Party, making choices, revisions and reversals interactively, in: Ümit Cizer: “Secular and Islamic Politics in Turkey”, (New York, Routledge, 2008), p. 3. Rabasa, Larrabee: The Rise of Political Islam, p. xv; Aydin, Çakır: Political Islam in Turkey, p. 1. كِرِم أوكْتِم: الأمة الغاضبة ص196؛ Rabasa, Larrabee: The Rise of Political Islam, p. 46-7. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص303. Ian o. Lesser: Turkey: “Recessed” Islamic Politics and Convergence with the West, in Angel M. Rabasa ... [et al.] “The Muslim world after 9/11” (Santa Monica, RAND, 2004), p175. Menderes Çınar, Burhanettin Duran: The specific evolution of contemporary Political Islam in Turkey and its ‘difference’, in Ümit Cizer: “Secular and Islamic Politics in Turkey”, p. 33. Ümit Cizer: The Justice and Development Party, p. 2.
كغيره من الأحزاب، واجه حزب العدالة والتنمية تحديات التأسيس: الرؤية الفكرية، الكوادر، البرنامج، الأموال. وكان عليه أن يعبر هذه التحديات في ظل واقع تتنازعه التوجهات؛ إذ هو يحتاج أن يثبت عدم تخليه عن الإسلام داخل بيئة التيار الإسلامي، ويحتاج أن يثبت أنه لم يخرج عن علمانية الجمهورية أمام الدولة العميقة، ويحتاج أن يثبت أنه صورة جديدة من "الإسلام السياسي" الذي يمكن للغرب أن يتفق معه وأن يجربه ويعتمد عليه، وكأنه يقدم "إسلاما جديدا" ملتزما بالثوابت التي تطرحها "الحضارة الغربية". ولم يكن بوسعه تقديم خطاب مزدوج في عصر ثورة الإعلام والاتصالات، فلا مناص حينئذ من خطاب دقيق ومتوازن، ثم من تنازلات وتضحيات ببعض الأطراف عند لحظات فارقة لا بد فيها من الاختيار حين لا ينفع التوازن والبقاء في منطقة رمادية.
بدأت المجموعة المؤسسة بإقامة مركزين للبحوث السياسية والفكرية: الأول مركز مؤسسة دنجه للأبحاث في أنقره والثاني مركز الأبحاث السياسية في اسطنبوللئن كانت الرؤية الفكرية أصعب شيء في تأسيس الأحزاب والجماعات والكيانات السياسية؛ إذ ينبني عليها سائر التوجهات والاختيارات، فلقد كانت في حالة حزب العدالة والتنمية أصعب؛ فالحزب تتنازعه جذوره الإسلامية مع ثوابت الدولة العلمانية التي يحرسها العسكر بقوة السلاح، وهذا كله تحت مظلة وضع دولي يثير حربا على "الإرهاب الإسلامي" بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وهذه الحرب على وشك أن تشتعل عند أطراف الثوب التركي: العراق!
لقد أثار الأمر خلافا بين المؤسسين، لكنهم خلصوا في النهاية إلى هذه الهوية ذات المساحات الرمادية، ولذا فمن أراد رؤيتهم كإسلاميين وَجَدَ في أدبياتهم ما يدعم خطه، ومن أراد رؤيتهم كعلمانيين وجد ما يدعم خطه، ومن أراد إثبات ما في خطابهم من ارتباك وتناقض وجد ما أراد كذلك، ويعلن كثير من الباحثينيبدو أردوغان إسلاميا عثمانيا يطرح نفسه كنقيض للحقبة الجمهورية العلمانية حين يقول في خطاب تأسيس الحزب (14 أغسطس 2001م) "تركيا لنا جميعا. إن تركيا منذ عام 1299م إلى عام 1923 كانت دائما تتولد منا نحن"ولكن يبدو مُنَظِّر الحزب، المفكر التركي أحمد أوزجان، متناقضا حين يقول في مرحلة التأسيس: "تركيا يجب أن تتخطى صراع الهيمنة والسيطرة الموجود بين الكتلة المسالمة والكتلة الكمالية. وعلى إنسان الأناضول أيضا أن يفرض على الساحة كادره الذي يُمَكّنه أن يحوي كلا الطرفين بداخله، والذي يخاطب الشعب بأكمله، وله هويته الإسلامية الخالصة، والذي ينتج ويعلن تجلياته الحقيقية"ومن المفهوم في عالم السياسة الحفاظ على مساحة من الغموض، كما في تصريح لعضو كبير بحزب العدالة والتنمية يقول: ليس المهم هو ما إذا كان الإسلام يؤثر في السياسة، ولكن "كيف" يكون هذا التأثير، فالتفسير الليبرالي للإسلام يؤثر في السياسة على نحو ليبراليلقد تمسك الحزب بإصرار –على مستوى الطرح الفكري- أنه يمكن الجمع بين كل ما يُظَنُّ أنه متناقض كما يقول أردوغان: "أنا حزبي محافظ ديمقراطي، محافظ أسعى للحفاظ على عاداتنا وتقاليدنا وثقافة الأمة التركية، وأسعى لتطبيق ديمقراطية قوية ومتطورة ولا تقل عن الديمقراطيات في العالم"ولئن صَعُب على الكثيرين ابتلاع هذا التوجه وفهمه، فإن الذي كان سهلا وواضحا وثابتا في رؤية الحزب وخطابه هو التخلي عن الخطاب المعادي للغرب الذي تبناه الإسلاميون سابقا، وتبنى خطابا متسقا مع ما يُطرح في المجتمعات الغربيةوما كان واضحا بذات الدرجة أنهم نقيض للاستبداد واعتبروا "ما يفعلونه بمثابة إحياء جديد لكل الأحزاب التي تم غلقها، وبمثابة عودة الفكر الوطني و(عودة لمن قُهِروا) من السياسيين"لقد مثلت هذه الطريقة نمطا جديدا في السياسة التي يتصدرها إسلاميون، ما جعلها مسرحا لابتكار الألفاظ والمصطلحات لدى الباحثين لمحاولة التعبير عن الظاهرة، فوُصِفَت بأنها "سياسة مرتاحة" يمثل الدين فيها إلهاما ثقافيا أكثر منه حضورا فاعلا في أجندة السياسةنشر في تركيا بوست
بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص306. برنامج تحت المجهر: "العثمانيون الجدد"، قناة الجزيرة، بتاريخ 26 يوليو 2007 كثير من الغموض أو الارتباك راجع أيضا إلى خلفيات الباحثين الفكرية، إذ الكثير يفهم الديمقراطية كنقيض للإسلام بغير اعتبار لما أفاض الإسلاميون في شرحه من تفريقهم بينها كفلسفة أو آليات، ونظرياتهم في تطبيق الإسلام في العالم المعاصر. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص327. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص304. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص309. Rabasa, Larrabee: The Rise of Political Islam, p. 54. محمد زاهد جل: التجربة النهضوية التركية ص16. محمد زاهد جل: التجربة النهضوية التركية ص89. برنامج تحت المجهر: "العثمانيون الجدد"، قناة الجزيرة، بث بتاريخ 26/7/2007؛ Rabasa, Larrabee: The Rise of Political Islam, p. 47. حوار مع عبد الله غل، برنامج حوار خاص، قناة الجزيرة، بتاريخ 22/11/2002. برنامج تحت المجهر: "العثمانيون الجدد"، قناة الجزيرة، بتاريخ 26 يوليو 2007 محمد زاهد جل: التجربة النهضوية التركية ص72. Rabasa, Larrabee: The Rise of Political Islam, p. 50; Ümit Cizer: The Justice and Development Party, making choices, revisions and reversals interactively, in: Ümit Cizer: “Secular and Islamic Politics in Turkey”, (New York, Routledge, 2008), p. 3. Rabasa, Larrabee: The Rise of Political Islam, p. xv; Aydin, Çakır: Political Islam in Turkey, p. 1. كِرِم أوكْتِم: الأمة الغاضبة ص196؛ Rabasa, Larrabee: The Rise of Political Islam, p. 46-7. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص303. Ian o. Lesser: Turkey: “Recessed” Islamic Politics and Convergence with the West, in Angel M. Rabasa ... [et al.] “The Muslim world after 9/11” (Santa Monica, RAND, 2004), p175. Menderes Çınar, Burhanettin Duran: The specific evolution of contemporary Political Islam in Turkey and its ‘difference’, in Ümit Cizer: “Secular and Islamic Politics in Turkey”, p. 33. Ümit Cizer: The Justice and Development Party, p. 2.
Published on May 10, 2016 13:22
May 9, 2016
رفع الظلم عن المماليك وتبرئتهم من المقارنة مع العسكر
لا يعرف التاريخَ من يشبه العسكر في عصرنا هذا بالمماليك في عصرهم، وقد بدأنا في المقال السابق حديثا عن رفع هذا الظلم عن المماليك، وتناولنا فيه الفارق بين العسكر الآن وبين المماليك في ثلاث أمور هي: حدود البلاد، الولاء للأمة، الحرب والجهاد. ورأينا كيف أن الفارق بينهما كما بين السماء والأرض، وكما بين الذل والمجد.
وبقي أن نشير إلى ثلاثة مجالات أخرى، لعل ذلك يزيد توضيح الصورة.
(4) الحالة العلمية
أشهر الأسماء العلمية في العالم الإسلامي إنما عاشوا في زمن المماليك، وهذه بعض أمثلة سريعة: العز بن عبد السلام، النووي، وابن منظور، والقلقشندي، وابن تيمية، المزي، ابن دقيق العيد، ابن القيم، الذهبي، ابن كثير، ابن رجب الحنبلي، الشاطبي، المقريزي، ابن تغري بردي، ابن خلدون، ابن حجر العسقلاني، السيوطي، السخاوي.
وأشهر الموسوعات العلمية في سائر العلوم الإسلامية وعامة تحريرات المذاهب الفقهية إنما ألفت في زمان المماليك، فمنها في التاريخ: تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء كلاهما للذهبي، ومنها في الرجال: الكمال في أسماء الرجال للمزي مع إكماله وتهذيبه وتذهيبه واختصاره، ومنها في الحديث: فتح الباري لابن حجر، ومنها في اللغة: لسان العرب لابن منظور، ومنها في الكتابة: صبح الأعشى للقلقشندي، ومنها في الأدب: نهاية الأرب للنويري، ومنها في تاريخ الطب: عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة... والأمثلة تطول جدا!
ومن أدل ما في شأن الحالة العلمية في ذلك العصر، ذلك الذي قاله ابن تيمية: "ليس عند أهل الكتاب فضيلة علمية وعملية إلا وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أكمل منهم فيها. فأما العلوم: فهم أحذق -في جميع العلوم- من جميع الأمم حتى العلوم التي ليست بنبوية، ولا أخروية، كعلم الطب -مثلا- والحساب، ونحو ذلك، هم أحذق فيها من الأمتين، ومصنفاتهم فيها أكمل من مصنفات الأمتين، بل أحسن علما وبيانا لها من الأولين الذين كانت هي غاية علمهم"وإلى نهاية عصر المماليك، الذي هو أحط فترات حكمهم، لا نعدم علما قائما في بلادهم يأتي إليه الطلاب من أوروبا نفسها، وقد روى الجبرتي أخبار ذلك في تاريخه، بل وشهد عدد من الغربيين أن مصر كانت على وشك نهضة لولا أن أوقفتها الحملة الفرنسيةصحيح أن المماليك لم يكونوا أهل علم وإنما كانوا أهل حكم، لكنهم لم يقفوا في وجه العلماء فلم يعطلوا العلم ولم يحاربوه كما يفعل عسكر هذا العصر الذين لا ينبغ في بلادهم أحد، بل إنما ينبغ من تركها ورحل إلى خارج حكمهم، ولا تجد العلماء إلا في الزنازين أو على المشانق.
(5) الآثار العمرانية
من زار القاهرة ودمشق ومتاحفهما يعرف بديع ما وصلت إليه العمارة والفنون الإسلامية في عصر المماليك، وفي القاهرة المسماة بمدينة الألف مئذنة لا تجد قبة تشبه القبة الأخرى في زخارفها، ولا مئذنة تشبه أخرى، ولا منبرا يشبه آخر، هذا مع انتشار المدارس والبيمارستانات (المستشفيات) التي كانت آية عصرها في حسن العمارة والترتيب والنظام، حتى وصف عصر المماليك بأنه العصر الذهبي للحضارة الإسلامية.
ولقد تفاجأ ابن خلدون عندما وصل القاهرة بما رآه فيها، رغم أنه كان وزيرا قبل ذلك في المغرب والأندلس، وسجَّل ذلك مشدوها بقوله: "فرأيت حاضرة الدنيا، وبستان العالم، ومحشر الأمم، ومَدْرَج الذرّ من البشر، وإيوان الإسلام، وكرسي الملك، تلوح القصور والأواوين في جوِّه، وتزهر الخوانق والمدارس والكواكب بآفاقه، وتضئ البدور والكواكب من علمائه... تزخر بالنعم، ومازلنا نتحدث بهذا البلد وبُعْدِ مداه في العمران واتساع الأحوال، ولقد اختلفت عبارات من لقيناه من شيوخنا وأصحابنا حاجِّهم وتاجرهم في الحديث عنه؛ سألت صاحبنا كبير الجماعة بفاس وكبير العلماء بالمغرب أبا عبد الله المقرى فقلت له: كيف هذه القاهرة؟ فقال: من لم يرها لم يعرف عز الإسلام"فأين هذا من عسكر ليست لهم مأثرة في بناء أو عمارة، بل استلموا البلاد وهي أجمل مدن الشرق، ثم تركوها يُضرب بها المثل في الفوضى والقذارة والخراب؟! رغم أنهم استلموها من احتلال أجنبي وحكموها بشعار وشرعية "التحرر والاستقلال الوطني"!!
(6) المآثر الحضارية
يتنازع المؤرخون مسألة المماليك والحضارة، يتهمهم البعض بأنهم كانوا نكبة على الحضارة ولا يوافقهم على هذا آخرون، ولسنا الآن بمقام الفصل في هذا النزاع، ولكن في مقام ذكر ما اتفقوا عليه.
ولقد اتفق المؤرخون والرحالة على سعة القاهرة المملوكية وعظمتها واتساعها وجمالها الأخاذ، وتفننوا في وصف سحرها الذي خلب الألباب، وإنما تنازعوا في مقدار ذلك: هل تساوي باريس في العظمة والاتساعولقد كانت القاهرة مركز التجارة العالمي في عصر المماليك تزخر بالدور والقصور والحدائق، ويشبهها الرحالة بفينيسيا حين يأتيها الفيضان ويرون أنها أكبر من ميلانو بست مرات! ويعتقد ستانلي لين بول أن القاهرة هي المدينة التي تخيلها كُتَّاب ألف ليلة وليلةفهل يفكر أحد الآن في القاهرة التي استلمها العسكر وهي أجمل مدن الشرق ثم لا تزداد معهم إلا سوءا وقبحا وفوضى وانهيارا في كل المجالات؟!
ونختم بمثل طريف، فمن مآثر المماليك الحضارية: المستشفى المنصوري التي بناها المنصور قلاوون، وهي أعجوبة عصرها، وكما وصفها المستشرق الفرنسي الشهير جومار "كان يدخله كل المرضى فقراء وأغنياء بدون تمييز، وكان يجلب إليه الأطباء من مختلف جهات الشرق ويجزل لهم العطاء... ويقال إن كل مريض كانت نفقاته في كل يوم دينارا، وكان له شخصان يقومان بخدمته، وكان المؤَرَّقون من المرضى يُعْزَلون في قاعة منفردة يشنفون فيها آذانهم بسماع ألحان الموسيقى الشجية أو يتسلون باستماع القصص يلقيها عليهم القُصَّاص... وكانت تمثل أمامهم الروايات المضحكة، وكان يُعطى لكل مريض حين خروجه من المارستان خمس قطع من الذهب حتى لا يضطر إلى الالتجاء إلى العمل الشاق في الحال"فهل صنع العسكر في بلادنا شيئا كهذا بعد ثمانية قرون؟!
لا ريب أن مقارنة العسكر الآن بالمماليك ظلم عظيم!
نشر في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية
ابن تيمية، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، 6/23. يراجع في ذلك: الجذور الإسلامية للرأسمالية للمؤرخ الأمريكي بيتر جران. ابن خلدون، تاريخ ان خلدون، تحقيق: خليل شحادة، ط2 (بيروت: دار الفكر، 1988م) 7/452. أفوقاي الأندلسي، رحلة أفوقاي الأندلسي، تحرير: د. محمد رزوق، ط1 (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2004م)، ص52. محمد عبد الستار عثمان، المدينة الإسلامية، سلسلة عالم المعرفة، 128، (الكويت: المجلس الأعلى للثقافة والآداب والفنون، أغسطس 1988م)، ص181. (وهو ينقل عن: الرحالة الفرنسي جيهان تود) أحمد عادل كمال، أطلس تاريخ القاهرة، (القاهرة: دار السلام، 2004م)، ص126. (وهو ينقل عن نشرة إنجليزية مطبوعة مع خريطة للقاهرة رسمت عام 972هـ = 1574م). أولج فولكف، القاهرة: مدينة ألف ليلة وليلة، ترجمة: أحمد صليحة، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1986م)، ص96. أحمد عادل كمال، أطلس تاريخ القاهرة، مرجع سابق، ص126. ستانلي لين بول، سيرة القاهرة، ترجمة: د. حسن إبراهيم حسن وآخران، ط2 (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، بدون تاريخ) ص220. أحمد عيسى بك، تاريخ البيمارستانات في الإسلام، ط2 (بيروت: دار الرائد العربي، 1981م)، ص101، 102.
وبقي أن نشير إلى ثلاثة مجالات أخرى، لعل ذلك يزيد توضيح الصورة.
(4) الحالة العلمية
أشهر الأسماء العلمية في العالم الإسلامي إنما عاشوا في زمن المماليك، وهذه بعض أمثلة سريعة: العز بن عبد السلام، النووي، وابن منظور، والقلقشندي، وابن تيمية، المزي، ابن دقيق العيد، ابن القيم، الذهبي، ابن كثير، ابن رجب الحنبلي، الشاطبي، المقريزي، ابن تغري بردي، ابن خلدون، ابن حجر العسقلاني، السيوطي، السخاوي.
وأشهر الموسوعات العلمية في سائر العلوم الإسلامية وعامة تحريرات المذاهب الفقهية إنما ألفت في زمان المماليك، فمنها في التاريخ: تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء كلاهما للذهبي، ومنها في الرجال: الكمال في أسماء الرجال للمزي مع إكماله وتهذيبه وتذهيبه واختصاره، ومنها في الحديث: فتح الباري لابن حجر، ومنها في اللغة: لسان العرب لابن منظور، ومنها في الكتابة: صبح الأعشى للقلقشندي، ومنها في الأدب: نهاية الأرب للنويري، ومنها في تاريخ الطب: عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة... والأمثلة تطول جدا!
ومن أدل ما في شأن الحالة العلمية في ذلك العصر، ذلك الذي قاله ابن تيمية: "ليس عند أهل الكتاب فضيلة علمية وعملية إلا وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أكمل منهم فيها. فأما العلوم: فهم أحذق -في جميع العلوم- من جميع الأمم حتى العلوم التي ليست بنبوية، ولا أخروية، كعلم الطب -مثلا- والحساب، ونحو ذلك، هم أحذق فيها من الأمتين، ومصنفاتهم فيها أكمل من مصنفات الأمتين، بل أحسن علما وبيانا لها من الأولين الذين كانت هي غاية علمهم"وإلى نهاية عصر المماليك، الذي هو أحط فترات حكمهم، لا نعدم علما قائما في بلادهم يأتي إليه الطلاب من أوروبا نفسها، وقد روى الجبرتي أخبار ذلك في تاريخه، بل وشهد عدد من الغربيين أن مصر كانت على وشك نهضة لولا أن أوقفتها الحملة الفرنسيةصحيح أن المماليك لم يكونوا أهل علم وإنما كانوا أهل حكم، لكنهم لم يقفوا في وجه العلماء فلم يعطلوا العلم ولم يحاربوه كما يفعل عسكر هذا العصر الذين لا ينبغ في بلادهم أحد، بل إنما ينبغ من تركها ورحل إلى خارج حكمهم، ولا تجد العلماء إلا في الزنازين أو على المشانق.
(5) الآثار العمرانية
من زار القاهرة ودمشق ومتاحفهما يعرف بديع ما وصلت إليه العمارة والفنون الإسلامية في عصر المماليك، وفي القاهرة المسماة بمدينة الألف مئذنة لا تجد قبة تشبه القبة الأخرى في زخارفها، ولا مئذنة تشبه أخرى، ولا منبرا يشبه آخر، هذا مع انتشار المدارس والبيمارستانات (المستشفيات) التي كانت آية عصرها في حسن العمارة والترتيب والنظام، حتى وصف عصر المماليك بأنه العصر الذهبي للحضارة الإسلامية.
ولقد تفاجأ ابن خلدون عندما وصل القاهرة بما رآه فيها، رغم أنه كان وزيرا قبل ذلك في المغرب والأندلس، وسجَّل ذلك مشدوها بقوله: "فرأيت حاضرة الدنيا، وبستان العالم، ومحشر الأمم، ومَدْرَج الذرّ من البشر، وإيوان الإسلام، وكرسي الملك، تلوح القصور والأواوين في جوِّه، وتزهر الخوانق والمدارس والكواكب بآفاقه، وتضئ البدور والكواكب من علمائه... تزخر بالنعم، ومازلنا نتحدث بهذا البلد وبُعْدِ مداه في العمران واتساع الأحوال، ولقد اختلفت عبارات من لقيناه من شيوخنا وأصحابنا حاجِّهم وتاجرهم في الحديث عنه؛ سألت صاحبنا كبير الجماعة بفاس وكبير العلماء بالمغرب أبا عبد الله المقرى فقلت له: كيف هذه القاهرة؟ فقال: من لم يرها لم يعرف عز الإسلام"فأين هذا من عسكر ليست لهم مأثرة في بناء أو عمارة، بل استلموا البلاد وهي أجمل مدن الشرق، ثم تركوها يُضرب بها المثل في الفوضى والقذارة والخراب؟! رغم أنهم استلموها من احتلال أجنبي وحكموها بشعار وشرعية "التحرر والاستقلال الوطني"!!
(6) المآثر الحضارية
يتنازع المؤرخون مسألة المماليك والحضارة، يتهمهم البعض بأنهم كانوا نكبة على الحضارة ولا يوافقهم على هذا آخرون، ولسنا الآن بمقام الفصل في هذا النزاع، ولكن في مقام ذكر ما اتفقوا عليه.
ولقد اتفق المؤرخون والرحالة على سعة القاهرة المملوكية وعظمتها واتساعها وجمالها الأخاذ، وتفننوا في وصف سحرها الذي خلب الألباب، وإنما تنازعوا في مقدار ذلك: هل تساوي باريس في العظمة والاتساعولقد كانت القاهرة مركز التجارة العالمي في عصر المماليك تزخر بالدور والقصور والحدائق، ويشبهها الرحالة بفينيسيا حين يأتيها الفيضان ويرون أنها أكبر من ميلانو بست مرات! ويعتقد ستانلي لين بول أن القاهرة هي المدينة التي تخيلها كُتَّاب ألف ليلة وليلةفهل يفكر أحد الآن في القاهرة التي استلمها العسكر وهي أجمل مدن الشرق ثم لا تزداد معهم إلا سوءا وقبحا وفوضى وانهيارا في كل المجالات؟!
ونختم بمثل طريف، فمن مآثر المماليك الحضارية: المستشفى المنصوري التي بناها المنصور قلاوون، وهي أعجوبة عصرها، وكما وصفها المستشرق الفرنسي الشهير جومار "كان يدخله كل المرضى فقراء وأغنياء بدون تمييز، وكان يجلب إليه الأطباء من مختلف جهات الشرق ويجزل لهم العطاء... ويقال إن كل مريض كانت نفقاته في كل يوم دينارا، وكان له شخصان يقومان بخدمته، وكان المؤَرَّقون من المرضى يُعْزَلون في قاعة منفردة يشنفون فيها آذانهم بسماع ألحان الموسيقى الشجية أو يتسلون باستماع القصص يلقيها عليهم القُصَّاص... وكانت تمثل أمامهم الروايات المضحكة، وكان يُعطى لكل مريض حين خروجه من المارستان خمس قطع من الذهب حتى لا يضطر إلى الالتجاء إلى العمل الشاق في الحال"فهل صنع العسكر في بلادنا شيئا كهذا بعد ثمانية قرون؟!
لا ريب أن مقارنة العسكر الآن بالمماليك ظلم عظيم!
نشر في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية
ابن تيمية، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، 6/23. يراجع في ذلك: الجذور الإسلامية للرأسمالية للمؤرخ الأمريكي بيتر جران. ابن خلدون، تاريخ ان خلدون، تحقيق: خليل شحادة، ط2 (بيروت: دار الفكر، 1988م) 7/452. أفوقاي الأندلسي، رحلة أفوقاي الأندلسي، تحرير: د. محمد رزوق، ط1 (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2004م)، ص52. محمد عبد الستار عثمان، المدينة الإسلامية، سلسلة عالم المعرفة، 128، (الكويت: المجلس الأعلى للثقافة والآداب والفنون، أغسطس 1988م)، ص181. (وهو ينقل عن: الرحالة الفرنسي جيهان تود) أحمد عادل كمال، أطلس تاريخ القاهرة، (القاهرة: دار السلام، 2004م)، ص126. (وهو ينقل عن نشرة إنجليزية مطبوعة مع خريطة للقاهرة رسمت عام 972هـ = 1574م). أولج فولكف، القاهرة: مدينة ألف ليلة وليلة، ترجمة: أحمد صليحة، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1986م)، ص96. أحمد عادل كمال، أطلس تاريخ القاهرة، مرجع سابق، ص126. ستانلي لين بول، سيرة القاهرة، ترجمة: د. حسن إبراهيم حسن وآخران، ط2 (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، بدون تاريخ) ص220. أحمد عيسى بك، تاريخ البيمارستانات في الإسلام، ط2 (بيروت: دار الرائد العربي، 1981م)، ص101، 102.
Published on May 09, 2016 08:56
April 28, 2016
خريطة مصر عبر العصور
[ملاحظة: كافة الخرائط الواردة في هذا المقال مأخوذة من كتاب أطلس تاريخ الإسلام للدكتور المؤرخ المعروف حسين مؤنس، وهو أبرز وأدق مجهود فيما أعلم في تتبع خرائط التاريخ الإسلامي]
منذ دخلت مصر في الإسلام وهي تتوسط عالمه الفسيح الذي امتد من حدود الصين شرقا إلى حدود فرنسا غربا، وكانت مصر ولاية بحد ذاتها، وهي –كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه- "ولاية جامعة تعدل الخلافة".
ثم جاءت عصور ضعفت فيه الخلافة الإسلامية وصارت لا تستطيع السيطرة على هذا المدى الواسع من العالم الإسلامي، وكان الأمويون العظام هم آخر من حكم العالم الإسلامي كله من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، فكان الخليفة الأموي ينفذ أمره في الأندلس كما ينفذ أمره في بلاد ما وراء النهر. ولم يستطع العباسيون أن يرثوا كل الدولة فقد خرجت الأندلس عن سلطانهم وبقيت فيها إمارة أموية، ومع ضعف الخلافة العباسية فيما بعد نشأت دول مستقلة على الحقيقة عند الأطراف وإن كانت تدين بالولاء الرسمي وبإعطاء الأموال للخلافة في بغداد، ثم تعددت هذه الدول، فصارت أول دولة تنشأ في مصر هي: الدولة الطولونية.
الدولة الطولونية
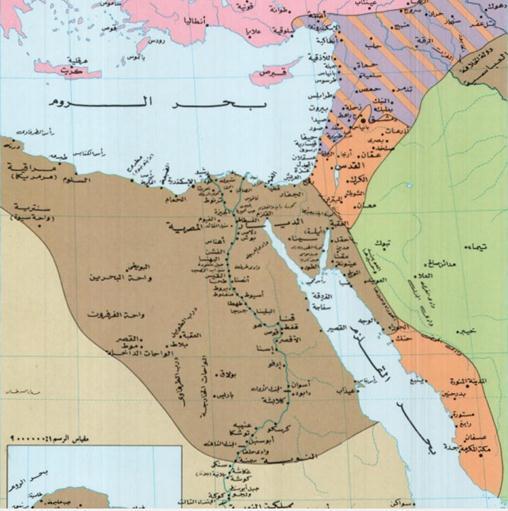
وهي الدولة التي أنشأها أحمد بن طولون الوالي على مصر، والذي استطاع أن يضم إلى سلطانه كل هذه البلاد الموضحة على الخريطة، بل واستطاع أن يقوم بواجب الجهاد في الثغور مع الروم إذ كانت الخلافة العباسية في وقته مستهلكة في محاربة التمردات عليها (الزنج في البصرة وجنوب العراق، والصفاريون في سجستان وما حولها)، وكانت دولة قوة وعز وخير وفير ولها إنجازات رائعة، ومن يقرأ في كتب تاريخ مصر يكاد يتخيل أنها جنة مزدهرة في ذلك الزمن.
الدولة الإخشيدية[نفس الخريطة السابقة مع إضافة المناطق البرتقالية]
وظهرت هذه الدولة عندما ضعفت الدولة الطولونية وانهارت، وبرز فيها الإخشيد كقائد عسكري استطاع صد العبيديين (الفاطميين) وإفشالهم من محاولة الاستيلاء على مصر، وكانت دولة قوية كذلك، وحاز سلطانها تلك الأراضي الموضحة في الخريطة.
الدولة العبيدية (الفاطمية)

والتي استطاعت بعد محاولات عديدة فاشلة أن تسيطر على مصر وتضمها إلى سلطانها الذي بدأ من المغرب وتمدد شرقا، ثم تابعت الاستيلاء على الأراضي حتى ضمت إليها الشام والحجاز، ومن العجيب أن دولة الفاطميين انقرضت في المغرب ثم انقرضت في الشام وطال زمانها في مصر. وبرغم كل مساوئ هذه الدولة وبعض الفترات العصيبة التي عاشتها مصر في ظلالها إلا أن مصر الغنية الوافرة المال كانت مزدهرة ناضرة في أيام خلفائهم الأقوياء.
الدولة الأيوبية
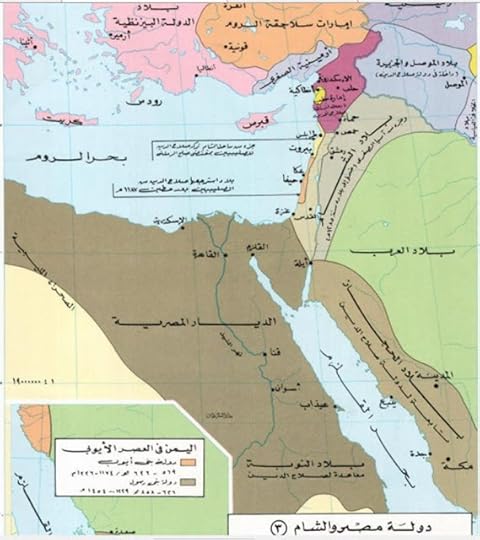
لما ضعفت الدولة العبيدية (الفاطمية) تعددت فيها مراكز وأجنحة القوى، فاستعان بعضها بالخارج على بعض، فاتجهوا إلى الشام الذي كان يشهد صراعا بين الصليبيين من ناحية والدولة الزنكية من ناحية أخرى، وكان كلا الطرفين يودَّ لو ضمَّ إليه مصر فيستقوي برجالها وأموالها، فالصليبيون يريدون تمديد وتعميق وجودهم في الشرق من بعد ما صار مهددا في الشام، والزنكيون يريدون إعادة وحدة الأمة تحت الخلافة العباسية السنية وإعادة وحدتها في الجهاد، وانتصر الزنكيون في هذا السباق بعد حروب في السياسة وفي القتال، وصار قائدهم العسكري صلاح الدين الأيوبي وزير الخلافة العبيدية في مصر، ثم استطاع بعد أمد إلغاءها وإعادة الوحدة السياسية، وانضمت مصر إلى معركة جهاد الأمة فما لبثت أن تحررت القدس بعد ذلك بأعوام.
وضمت الدولة الأيوبية هذه المساحة (المبينة بالخريطة) من البلاد، واستعانت بكل هذا على حرب الصليبيين، وأفشلت الدولة الأيوبية حملتين من ثلاث حملات صليبية جديدة (الخامسة والسابعة) ولولا سوء السياسة لفشلت الحملة السادسة كذلك، فمنذ توحدت الشام ومصر صار الصليبيون في خطر حقيقي، وصار وجودهم في الشام مسألة وقت.
الدولة المملوكية

وهي التي ورثت الدولة الأيوبية بعد تفككها وانقسامها وخلوها من الرجال الأقوياء، وافتتحت عهدها بوقف العاصفة المغولية في عين جالوت، ثم في غيرها من المعارك التي أنهت تماما الخطر المغولي وصدته عن الديار الإسلامية، ثم استأنفت مسيرة تطهير الشام من الوجود الصليبي فأنجزت هذه المهمة، ثم طاردت فلول الصليبيين حتى حررت قبرص وهددت جزيرة رودس، وفي عصرهم صار الخليفة العباسي مقيما في مصر، وصارت القاهرة عاصمة الخلافة.
وكانت دولة قوة وفتوة وعمارة وجهاد، وإلى عهد المماليك ينتسب الجمهور الأعظم من العلماء المسلمين المشهورين في مصر والشام كالعز بن عبد السلام والنووي وابن دقيق العيد والشاطبي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير والذهبي وابن حجر العسقلاني والمقريزي وابن خلدون وابن تغري بردي وغيرهم كثيرون جدا.
ثم دخلت مصر في السلطنة العثمانية، وصارت ولاية تابعة للعثمانيين فعادت لمرة أخرى ولاية ضمن ولايات الدولة بغير نوع استقلال ومركزية استمر فيها لسبعة قرون، إلا أن الحكام الفعليون –بعد فترة وجيزة- كانوا هم المماليك وكان الباشا العثماني مجرد اسم ورسم لا حكم له على الحقيقة.
دولة محمد علي
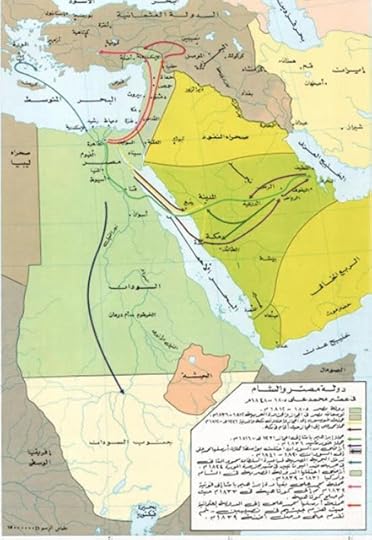
استعادت مصر نوع استقلاليتها ومركزيتها ضمن ولايات الخلافة في عهد محمد علي الذي رغم كل كوارثه ومآسيه ونكباته كان بركانا من النشاط والقوة، وأسس في مصر جيشا حديثا استطاع أن يمد نفوذه إلى هذه المناطق (المبينة بالخريطة) وأن يهدد الدولة العثمانية نفسها، بل وكاد ينهيها لولا أن وقفت الدول الغربية مع العثمانيين وردت محمد إلى الشام ومصر ثم إلى مصر وفرضت عليه معاهدة (1840) المذلة التي قلمت أظافره.
وكانت دولته دولة ثروة ونفوذ وقوة وجيش، كما كانت دولة قهر وظلم وعسف وتسلط للأجانب على أهل البلد، وهو مؤسس الدولة "الحديثة" كنظام ونمط علماني مأخوذ من أوروبا، وكان ينظر إلى البلاد وأهلها كالبقرة الحلوب، يحتاج أن يسمنها ليأكل منها أكلا وفيرا ويورثها لأبنائها.
دولة أبناء محمد علي

وهي الدولة التي بقيت فيها آثار ونكبات محمد علي دون ميزاته وحسناته، وتكاد تنحصر في ابنه سعيد وحفيده إسماعيل، وكلاهما كانا يسيطران على هذه المساحة (المبينة بالخريطة) وكانت البلاد رغم ما فيها من الخير والبركة قد ضاقت بأبنائها وصار خيرها مصروفا إلى الأجانب الذين تغولوا وتفحشوا وتسلطوا وتسلطنوا حتى صاروا أقوى من الخديوي نفسه، بل صار الأجانب أعضاء في الحكومة ومحاكمهم تقضي على الخديوي نفسه وصاروا قادة الجيش المصري والمتحكمين بالتجارة، وفازوا في هذا العصر بما لم يحلم به مستعمر قبلهم (قناة السويس)، وما إن كاد الشعب المصري يسترد بعض حقه وحريته حتى نزل الاحتلال الإنجليزي ليحافظ على النظام التابع له ويقضي تماما على محاولة الثورة.
الاحتلال الإنجليزي
وهو كأي دولة احتلال لا نطيل الحديث في شأنه، ولكن الذي يهمنا في هذا السياق هو تقلص المساحة التي تسيطر عليها مصر، بالفصل العملي –لا الرسمي- للسودان، فخسرت مصر ثلثي أراضيها، إلا أن الاحتلال الإنجليزي –المضروب به المثل في الدهاء والمكر- صنع كل هذا بأيادي مصرية وسياسات ينفذها مصريون واتفاقيات يوقع عليها مصريون، وسمح كذلك بالمعارضة السياسية في مصر والتي كانت في غاية القوة برغم كونها تحت الاحتلال (وللعلم فإن مستوى حرية الإعلام في عهد الاحتلال لا يقارن أبدا بمستواه في عهد العسكر فيما بعد)، وكان من آثار هذا أنه وفي أواخر عصر الاحتلال الإنجليزي لم يجرؤ أحد على إعلان التخلي عن السودان، ولا الملك فاروق رغم كل ضعفه وكل فساده، ولا زعيم حزب الوفد رغم كل ما يؤخذ عليه وعلى الوفد من سياسات، ولم يعد بالإمكان –كما تبين وثائق المخابرات الأمريكية فيما بعد- طرح مطلب فصل السودان إلا بإلغاء الملكية كنظام سياسي والإتيان بنظام جمهوري يوافق على الفصل، وهو ما فعله العسكر بعد انقلاب يوليو، ولم تخرج بريطانيا من مصر إلا بعد الاتفاق على فصل السودان.
دولة العسكر
وهي أسوأ مرحلة مرت على مصر في كل تاريخها، فسائر المراحل التاريخية السابقة إما شهدت استبدادا بمعنى الاستبداد الوطني الذي ينتمي فيه المستبد إلى هذا الوطن ولا يعرف له ولاء ولا انتماءا لغيره، ولهذا فهو إذا جد الجد وحان وقت الحرب حارب دفاعا عن نفسه وعن ملكه، وإما شهدت احتلالا صريحا أجنبيا معزولا عن الشعب وهو مع هذا كان خيرا من حكم العسكر.
أما عصر العسكر فقد انتهت فيه مكانة مصر حتى بين العرب والمسلمين، وتقلصت فيه حدودها بفصل السودان وترك غزة وضياع سيناء (والتي ما تزال حتى الآن تحت النفوذ والهيمنة الإسرائيلية عمليا) وتهاوت فيه مصر اقتصاديا وسياسيا وعلميا وثقافيا واجتماعيا، ونزلت بها هزائم تاريخية ساحقة على يد إسرائيل، ثم هي أيضا تحت النفوذ الأجنبي سياسيا واقتصاديا وثقافيا، ووصل الحال إلى أن قادة جيشها يفخرون بأنهم جزء من الأمن القومي الأمريكي ويحتفلون بمرور مائة عام على مجهودهم في الحرب العالمية الأولى خدمة للإنجليز ضد العثمانيين والسودانيين والليبيين.
وصارت خريطة مصر هي الخريطة الأصغر بين سائر هذه العصور وهذه الخرائط، وهي الخريطة المعروفة للجميع.
نشر في ساسة بوست
منذ دخلت مصر في الإسلام وهي تتوسط عالمه الفسيح الذي امتد من حدود الصين شرقا إلى حدود فرنسا غربا، وكانت مصر ولاية بحد ذاتها، وهي –كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه- "ولاية جامعة تعدل الخلافة".
ثم جاءت عصور ضعفت فيه الخلافة الإسلامية وصارت لا تستطيع السيطرة على هذا المدى الواسع من العالم الإسلامي، وكان الأمويون العظام هم آخر من حكم العالم الإسلامي كله من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، فكان الخليفة الأموي ينفذ أمره في الأندلس كما ينفذ أمره في بلاد ما وراء النهر. ولم يستطع العباسيون أن يرثوا كل الدولة فقد خرجت الأندلس عن سلطانهم وبقيت فيها إمارة أموية، ومع ضعف الخلافة العباسية فيما بعد نشأت دول مستقلة على الحقيقة عند الأطراف وإن كانت تدين بالولاء الرسمي وبإعطاء الأموال للخلافة في بغداد، ثم تعددت هذه الدول، فصارت أول دولة تنشأ في مصر هي: الدولة الطولونية.
الدولة الطولونية
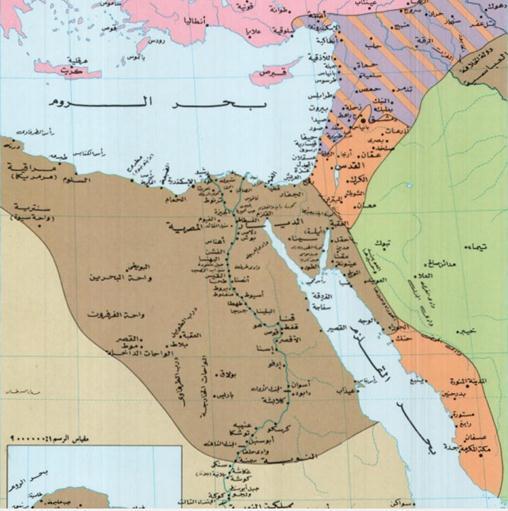
وهي الدولة التي أنشأها أحمد بن طولون الوالي على مصر، والذي استطاع أن يضم إلى سلطانه كل هذه البلاد الموضحة على الخريطة، بل واستطاع أن يقوم بواجب الجهاد في الثغور مع الروم إذ كانت الخلافة العباسية في وقته مستهلكة في محاربة التمردات عليها (الزنج في البصرة وجنوب العراق، والصفاريون في سجستان وما حولها)، وكانت دولة قوة وعز وخير وفير ولها إنجازات رائعة، ومن يقرأ في كتب تاريخ مصر يكاد يتخيل أنها جنة مزدهرة في ذلك الزمن.
الدولة الإخشيدية[نفس الخريطة السابقة مع إضافة المناطق البرتقالية]
وظهرت هذه الدولة عندما ضعفت الدولة الطولونية وانهارت، وبرز فيها الإخشيد كقائد عسكري استطاع صد العبيديين (الفاطميين) وإفشالهم من محاولة الاستيلاء على مصر، وكانت دولة قوية كذلك، وحاز سلطانها تلك الأراضي الموضحة في الخريطة.
الدولة العبيدية (الفاطمية)

والتي استطاعت بعد محاولات عديدة فاشلة أن تسيطر على مصر وتضمها إلى سلطانها الذي بدأ من المغرب وتمدد شرقا، ثم تابعت الاستيلاء على الأراضي حتى ضمت إليها الشام والحجاز، ومن العجيب أن دولة الفاطميين انقرضت في المغرب ثم انقرضت في الشام وطال زمانها في مصر. وبرغم كل مساوئ هذه الدولة وبعض الفترات العصيبة التي عاشتها مصر في ظلالها إلا أن مصر الغنية الوافرة المال كانت مزدهرة ناضرة في أيام خلفائهم الأقوياء.
الدولة الأيوبية
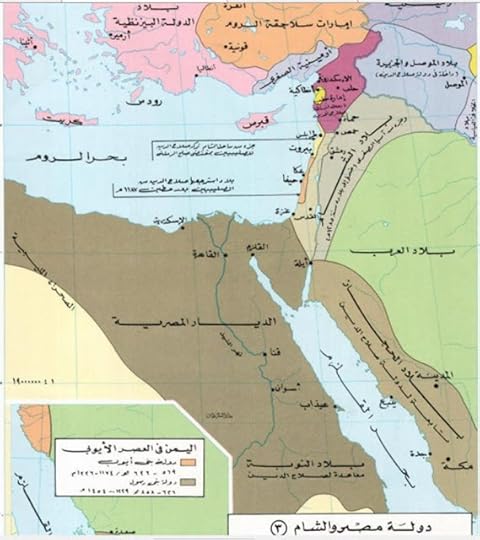
لما ضعفت الدولة العبيدية (الفاطمية) تعددت فيها مراكز وأجنحة القوى، فاستعان بعضها بالخارج على بعض، فاتجهوا إلى الشام الذي كان يشهد صراعا بين الصليبيين من ناحية والدولة الزنكية من ناحية أخرى، وكان كلا الطرفين يودَّ لو ضمَّ إليه مصر فيستقوي برجالها وأموالها، فالصليبيون يريدون تمديد وتعميق وجودهم في الشرق من بعد ما صار مهددا في الشام، والزنكيون يريدون إعادة وحدة الأمة تحت الخلافة العباسية السنية وإعادة وحدتها في الجهاد، وانتصر الزنكيون في هذا السباق بعد حروب في السياسة وفي القتال، وصار قائدهم العسكري صلاح الدين الأيوبي وزير الخلافة العبيدية في مصر، ثم استطاع بعد أمد إلغاءها وإعادة الوحدة السياسية، وانضمت مصر إلى معركة جهاد الأمة فما لبثت أن تحررت القدس بعد ذلك بأعوام.
وضمت الدولة الأيوبية هذه المساحة (المبينة بالخريطة) من البلاد، واستعانت بكل هذا على حرب الصليبيين، وأفشلت الدولة الأيوبية حملتين من ثلاث حملات صليبية جديدة (الخامسة والسابعة) ولولا سوء السياسة لفشلت الحملة السادسة كذلك، فمنذ توحدت الشام ومصر صار الصليبيون في خطر حقيقي، وصار وجودهم في الشام مسألة وقت.
الدولة المملوكية

وهي التي ورثت الدولة الأيوبية بعد تفككها وانقسامها وخلوها من الرجال الأقوياء، وافتتحت عهدها بوقف العاصفة المغولية في عين جالوت، ثم في غيرها من المعارك التي أنهت تماما الخطر المغولي وصدته عن الديار الإسلامية، ثم استأنفت مسيرة تطهير الشام من الوجود الصليبي فأنجزت هذه المهمة، ثم طاردت فلول الصليبيين حتى حررت قبرص وهددت جزيرة رودس، وفي عصرهم صار الخليفة العباسي مقيما في مصر، وصارت القاهرة عاصمة الخلافة.
وكانت دولة قوة وفتوة وعمارة وجهاد، وإلى عهد المماليك ينتسب الجمهور الأعظم من العلماء المسلمين المشهورين في مصر والشام كالعز بن عبد السلام والنووي وابن دقيق العيد والشاطبي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير والذهبي وابن حجر العسقلاني والمقريزي وابن خلدون وابن تغري بردي وغيرهم كثيرون جدا.
ثم دخلت مصر في السلطنة العثمانية، وصارت ولاية تابعة للعثمانيين فعادت لمرة أخرى ولاية ضمن ولايات الدولة بغير نوع استقلال ومركزية استمر فيها لسبعة قرون، إلا أن الحكام الفعليون –بعد فترة وجيزة- كانوا هم المماليك وكان الباشا العثماني مجرد اسم ورسم لا حكم له على الحقيقة.
دولة محمد علي
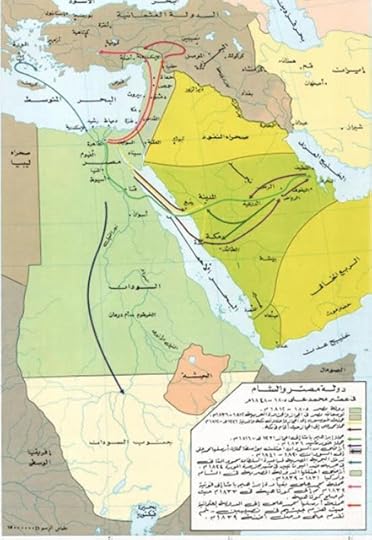
استعادت مصر نوع استقلاليتها ومركزيتها ضمن ولايات الخلافة في عهد محمد علي الذي رغم كل كوارثه ومآسيه ونكباته كان بركانا من النشاط والقوة، وأسس في مصر جيشا حديثا استطاع أن يمد نفوذه إلى هذه المناطق (المبينة بالخريطة) وأن يهدد الدولة العثمانية نفسها، بل وكاد ينهيها لولا أن وقفت الدول الغربية مع العثمانيين وردت محمد إلى الشام ومصر ثم إلى مصر وفرضت عليه معاهدة (1840) المذلة التي قلمت أظافره.
وكانت دولته دولة ثروة ونفوذ وقوة وجيش، كما كانت دولة قهر وظلم وعسف وتسلط للأجانب على أهل البلد، وهو مؤسس الدولة "الحديثة" كنظام ونمط علماني مأخوذ من أوروبا، وكان ينظر إلى البلاد وأهلها كالبقرة الحلوب، يحتاج أن يسمنها ليأكل منها أكلا وفيرا ويورثها لأبنائها.
دولة أبناء محمد علي

وهي الدولة التي بقيت فيها آثار ونكبات محمد علي دون ميزاته وحسناته، وتكاد تنحصر في ابنه سعيد وحفيده إسماعيل، وكلاهما كانا يسيطران على هذه المساحة (المبينة بالخريطة) وكانت البلاد رغم ما فيها من الخير والبركة قد ضاقت بأبنائها وصار خيرها مصروفا إلى الأجانب الذين تغولوا وتفحشوا وتسلطوا وتسلطنوا حتى صاروا أقوى من الخديوي نفسه، بل صار الأجانب أعضاء في الحكومة ومحاكمهم تقضي على الخديوي نفسه وصاروا قادة الجيش المصري والمتحكمين بالتجارة، وفازوا في هذا العصر بما لم يحلم به مستعمر قبلهم (قناة السويس)، وما إن كاد الشعب المصري يسترد بعض حقه وحريته حتى نزل الاحتلال الإنجليزي ليحافظ على النظام التابع له ويقضي تماما على محاولة الثورة.
الاحتلال الإنجليزي
وهو كأي دولة احتلال لا نطيل الحديث في شأنه، ولكن الذي يهمنا في هذا السياق هو تقلص المساحة التي تسيطر عليها مصر، بالفصل العملي –لا الرسمي- للسودان، فخسرت مصر ثلثي أراضيها، إلا أن الاحتلال الإنجليزي –المضروب به المثل في الدهاء والمكر- صنع كل هذا بأيادي مصرية وسياسات ينفذها مصريون واتفاقيات يوقع عليها مصريون، وسمح كذلك بالمعارضة السياسية في مصر والتي كانت في غاية القوة برغم كونها تحت الاحتلال (وللعلم فإن مستوى حرية الإعلام في عهد الاحتلال لا يقارن أبدا بمستواه في عهد العسكر فيما بعد)، وكان من آثار هذا أنه وفي أواخر عصر الاحتلال الإنجليزي لم يجرؤ أحد على إعلان التخلي عن السودان، ولا الملك فاروق رغم كل ضعفه وكل فساده، ولا زعيم حزب الوفد رغم كل ما يؤخذ عليه وعلى الوفد من سياسات، ولم يعد بالإمكان –كما تبين وثائق المخابرات الأمريكية فيما بعد- طرح مطلب فصل السودان إلا بإلغاء الملكية كنظام سياسي والإتيان بنظام جمهوري يوافق على الفصل، وهو ما فعله العسكر بعد انقلاب يوليو، ولم تخرج بريطانيا من مصر إلا بعد الاتفاق على فصل السودان.
دولة العسكر
وهي أسوأ مرحلة مرت على مصر في كل تاريخها، فسائر المراحل التاريخية السابقة إما شهدت استبدادا بمعنى الاستبداد الوطني الذي ينتمي فيه المستبد إلى هذا الوطن ولا يعرف له ولاء ولا انتماءا لغيره، ولهذا فهو إذا جد الجد وحان وقت الحرب حارب دفاعا عن نفسه وعن ملكه، وإما شهدت احتلالا صريحا أجنبيا معزولا عن الشعب وهو مع هذا كان خيرا من حكم العسكر.
أما عصر العسكر فقد انتهت فيه مكانة مصر حتى بين العرب والمسلمين، وتقلصت فيه حدودها بفصل السودان وترك غزة وضياع سيناء (والتي ما تزال حتى الآن تحت النفوذ والهيمنة الإسرائيلية عمليا) وتهاوت فيه مصر اقتصاديا وسياسيا وعلميا وثقافيا واجتماعيا، ونزلت بها هزائم تاريخية ساحقة على يد إسرائيل، ثم هي أيضا تحت النفوذ الأجنبي سياسيا واقتصاديا وثقافيا، ووصل الحال إلى أن قادة جيشها يفخرون بأنهم جزء من الأمن القومي الأمريكي ويحتفلون بمرور مائة عام على مجهودهم في الحرب العالمية الأولى خدمة للإنجليز ضد العثمانيين والسودانيين والليبيين.
وصارت خريطة مصر هي الخريطة الأصغر بين سائر هذه العصور وهذه الخرائط، وهي الخريطة المعروفة للجميع.
نشر في ساسة بوست
Published on April 28, 2016 18:37
April 26, 2016
حقوق الإنسان في فكر السياسة التركية
رغم ما يبدو أول الأمر من بساطة الكتابة في مسألة "تميز تركيا في حقوق الإنسان"، إلا أن الواقع بخلاف ذلك، وذلك أن ملف تقدم تركيا في حقوق الإنسان من الملفات التي تواطأ الجميع على كتمانها، وكان شيخنا محمد الغزالي يقول: "ما رأيت أحدا تواطأ الناس على هضمه كالحقيقة".
إن الدراسات والتقارير الغربية لا تركز على حقوق الإنسان كما هو المتوقع –ولو زَعْمًا- بقدر ما تركز على النموذج التركي من حيث خطورته على أوروبا، ومدى عودته إلى هويته الإسلامية، ومدى الرضا العلماني والعسكري عن نموذج حزب العدالة والتنمية. بل حتى التقارير الحقوقية الغربية –وقد طالعت عددا مما صدر في السنوات الأخيرة- تشبه المنشورات ضد السياسة التركية.
وفي المقابل فإن الدراسات العربية تركز على رصد ومتابعة النموذج التركي في السياسة والاقتصاد والتأثير على العالم العربي والموقف من القضايا العربية، ولا تحفل بمسألة تطور وضع حقوق الإنسان في تركيا، اللهم إلا الأطراف المعادية لتركيا فإنها تهتم بهذا الجانب مستخدمة إياه في تشويه ومهاجمة السياسة التركية في حقبتها الجديدة.
هذا الذي تجاهلته –أو زيفته التقارير- كان يخالف واقعا عشته بنفسي لعام ونصف في تركيا، وعاشه معي ملايين المهاجرين والمطاردين من العالم العربي، ولذلك كان الحصول على الحقيقة الموثقة بالأرقام من خلال دراسات ميدانية أمرا عسيرا، حتى أنني استعنت ببعض الأصدقاء الأتراك والعرب العاملين في مجال الإعلام التركي للحصول على دراسات معمقة عن تطور حقوق الإنسان في تركيا، وكانت الإجابة مخيبة للآمال كذلك.
عندئذ ذهبت إلى البحث عن معنى حقوق الإنسان في فكر وفلسفة حزب العدالة والتنمية، وفي أبرز النصوص المكتوبة المعبرة عن هذا التفكير.
إن كل زعماء العالم –حتى أشدهم طغيانا وانتهاكا لحقوق الإنسان- يتغنى بحقوق الإنسان، ويدرج في خطاباته وتصريحاته عبارات محفوظة مكرورة مملولة، لكن ما وجدته في الأدبيات الفكرية للحزب يعبر عن فكر ورؤية وعمق لا عن مجرد زخارف ومحسنات كلامية.
إن العمق الذي يكتبه فيلسوف الحزب ورئيسه الآن، أحمد داود أوغلو، يذهب حتى يحلل البنية التي تحكم الإنسان في النظام السياسي، ولذلك جاءت كتبه كدروس معمقة في نقد النموذج الغربي الذي ظاهره الحفاظ على حقوق الإنسان بينما حقيقته التحكم بالإنسان والتسلط عليه. وإثبات تفوق النموذج الإسلامي الذي سلب الإنسان حق التسلط والتحكم بالإنسان.
ففي كتابه "الفلسفة السياسية" يعزو تناقض النموذجين الغربي والإسلامي إلى أن الأول دائما وفي شتى تصوراته الفلسفية –القديمة والوسيطة والحديثة- الفوارق بين الله والإنسان، فمنح الإنسان سلطة إلهية مما ترتبت عليه آثار بعيدة في النظام السياسي، بينما حرص النموذج الإسلامي على التوحيد الذي يجعل الإنسان مفارقا لله ولا يمكن أن يحوز سلطة إلهية مما كان له آثاره الهائلة في النظام السياسي. ويجدر النظر إلى أن هذا الكتاب صدر عام 1993م، أي قبل وجود حزب العدالة والتنمية بقرابة العقد من الزمن.
وفي كتابه "العالم الإسلامي في مهب التحولات الحضارية"، والذي صدر قبل ميلاد الحزب بثمانية أعوام، يرصد داود أوغلو كيف أنه "في الحضارة الغربية يتولد الاختلال الأخلاقي من اعتمادية المعرفة على مؤسسة السلطة، والتي بدورها تعمل داخل إطار استبدادي بسبب قدرة مراكز القوى على إنتاج معرفة مناسبة كافية لتوليد نظام قيمي ملائم يعمل لمصالحها الذاتية"وفي كتابه الأهم "العمق الاستراتيجي"، والذي يرسم فيه مستقبل الدولة التركية، يؤسس لنظرة نحو الإنسان يقول فيها: "أكثر العناصر حساسية في الانفتاح الاستراتيجي للدولة هو العلاقة المشروعة بين الإرادة السياسية لمركز النظام وبين العنصر البشري المؤهل للمجتمع المدني. وإذا أردنا التعبير عن ذلك بتعبيرات تُستخدم كثيرا في الوقت المعاصر فإنه يمكن وصف هذه العلاقة بنقطة الالتقاء بين "عمق الدولة" و"عمق الأمة". إن الدولة التي لم تصل إلى عمق الأمة، ولم تحقق معه وحدة روحية نابعة عن نظام القيم المشتركة، لن ينتج عنها إلا صورة سيئة للقوة. إن أهم بعد للعلاقة المشروعة بين العنصر البشري والنظام السياسي هو عنصر الثقة؛ فالدولة التي لا تثق بعنصرها البشري لا يمكنها الانفتاح على آفاق استراتيجية، بحيث تضع أهدافا تكتيكية لتحريك القوى الكامنة للمجتمتع، أو أن تستخدم الوسائل المناسبة لهذه الأهداف في التوقيت الصحيح والمناسب"هذه الرؤية العميقة لجوهر حقوق الإنسان ومدى توفرها في بيئة النظام السياسي القائمة، موجودة أيضا منذ قديم عند مؤسس الحزب وزعيمه رجب طيب أردوغان، ففي كلمته التي ألقاها في ختام مؤتمر الديمقراطية (1997م) نظَّر لضرورة أن يضيف المجتمع "أحكام قِيَمه ومعتقداته وعاداته وتقاليده باعتبارها خميرة الثقافة السياسية لهذه التجربة الديمقراطية"، وعندئذ تخرج الديمقراطية من كونها ثرثرة نخبوية بل ووسيلة من وسائل الاستبداد والتسلط النخبوي على المجتمع لتكون روحا حقيقية يؤديها المجتمع كواجبات يومية، ويغذي بها قناعاته الثقافيةنحن هنا أمام تحليل أعمق لمسألة حقوق الإنسان، إنه في جوهره نقد للنموذج الغربي الذي يصطنع شكلا آخر من العبودية والتحكم ثم يلبسها ثوب الحرية ولافتة الديمقراطية وعنوان الانتخابات، وهو نقدٌ يُبنى عليه رؤية أخرى مفادها علاقة صحيحة سوية بين الدولة والأمة، أو بين "عمق الدولة وعمق الأمة" بتعبير داود أوغلو. وهذا المعنى يتردد كثيرا في خطابات وكلمات أردوغان، لكننا نكتفي هنا بأقواها في الدلالة:
1. "لا يمكن لدولة إنسانها ضعيف أن تكون قوية"ديار بكر – 24 يونيو 2007
2. "بالنسبة لنا كل إنسان خاص، وكل إنسان غال وقيّم. لكل إنسا الحق في امتلاك الفرص والحقوق التي يستحقها"اجتماع الكتلة البرلمانية – 13 مايو 2008
3. "الإنسان أساس كل شيء. ولذلك يجب أن تصنع السياسة من أجل سعادة الإنسان وراحته، سلامته وطمأنينته"مؤتمر حزب العدالة والتنمية – 3 أكتوبر 2009
4. "الإنسان أولا، ومن ثَمَّ تأتي الدولة. وليست الدولة هي الأولى ليأتي الإنسان بعدها"الاجتماع الاستشاري - 22 نوفمبر 2009
5. "في هذا البلد ستنهار البنية الإقطاعية بالتأكيد، ويجب عليها أن تنهار وأن تنحط، لأننا لا نقبل عبودية الإنسان للإنسان. وخصوصا في قيمنا الحضارية، لا عبودية لدينا لغير الخالق. ولهذا السبب: إن السيادة للأمة دون قيد أو شرط"سيرت – 6 مايو 2005
6. "الحقائق، الحقوق والحريات لا تتغير وفقا للأشخاص. الحقيقة هي حقيقة في كل زمان ومكان"اجتماع رؤساء المقاطعات – 21 مارس 2008
7. "يجب علينا جميعا أن نعلم أننا متساوون كأسنان المشط في القاسم المشترك بيننا وهو الإنسانية، سواء منا الشرقي والغربي، المسلم والمسيحي، المتدين والعلماني، الغني والفقير، الأبيض والأسود"أمريكا – 7 ديسمبر 2009
بقيت نقطة، وقد أجلتها إلى نهاية الورقة لأنها ذات دلالة في منهج التعامل الغربي مع حقوق الإنسان في تركيا، وهي: القضية الكردية.
إن القضية الكردية حاضرة في كل دراسة أو تقرير عن الحالة التركية، وكثيرا ما حضرت في الماضي من بوابة حقوق الإنسان، وبغير شك فإن الأكراد عانوا كثيرا لنحو قرن من الزمن، وكانوا من الفئات التي سحقتها السياسات القديمة، إلا أن السياسات الجديدة مثلت تحولا كبيرا في التعامل مع الملف الكردي، غير أن التقارير الحقوقية لا تأبه كثيرا لما تحقق وتركز على ما لم يتحقق بعد، وبالعموم، فإن الدراسات الغربية عن تركيا تنظر إلى القضية الكردية كمدخل لعدم استقرار تركيا لا كمدخل لاستقرارها بتعديل الأوضاع السيئة الموروثة. ولذلك فهي تمر على التحسن بعبارة أو بضع عبارة، بينما تفرد باقي الصفحات لرصد المخالفات مع مساحة من التعنت والتعسف ظاهرة وواضحة.إن مسألة حقوق الإنسان في تركيا هي من الحقائق الواضحة التي يعد البحث عن أدلة وجودها تعسف، كقول الشاعر:وليس يصح في الأذهان شيء .. إذا احتاج النهار إلى دليلأو كقول الآخر:فقد تنكر العين نور الشمس من رمد .. وينكر الفم طعم الماء من سقم
فالدليل هو ملايين المهاجرين المتدفقين على تركيا من سائر أنحاء العالم الإسلامي، فكلٌ منهم دليلٌ على الواقع، فضلا عما لقيه هؤلاء من ضيافة وحسن ترحاب من إخوانهم الأتراك، وليس يعرف طعم الأمن إلا من ذاق الخوف. والحق أن منح الخائفين الأمان لا يقل بحال عن منح الجائعين الطعام ومنح الظامئين الشراب، بل لربما يزيد، إذ جوهر تميز الإنسان عن الحيوان هو شعوره بهذا الأمن الذي يعيد إليه شعوره بإنسانيته التي ما هاجر وترك بلده إلا لأنها سُحقِت أو كادت تُسْحق وتموت!
ولهذا أردد مع جميع إخواني: شكرا تركيا..
نشر في تركيا بوست
العالم الإسلامي في مهب التحولات الحضارية ص130. العمق الاستراتيجي ص58. حسين بسلي وعمر أوزباي: رجب طيب أردوغان.. قصة زعيم ص231. المصدر السابق ص241.
إن الدراسات والتقارير الغربية لا تركز على حقوق الإنسان كما هو المتوقع –ولو زَعْمًا- بقدر ما تركز على النموذج التركي من حيث خطورته على أوروبا، ومدى عودته إلى هويته الإسلامية، ومدى الرضا العلماني والعسكري عن نموذج حزب العدالة والتنمية. بل حتى التقارير الحقوقية الغربية –وقد طالعت عددا مما صدر في السنوات الأخيرة- تشبه المنشورات ضد السياسة التركية.
وفي المقابل فإن الدراسات العربية تركز على رصد ومتابعة النموذج التركي في السياسة والاقتصاد والتأثير على العالم العربي والموقف من القضايا العربية، ولا تحفل بمسألة تطور وضع حقوق الإنسان في تركيا، اللهم إلا الأطراف المعادية لتركيا فإنها تهتم بهذا الجانب مستخدمة إياه في تشويه ومهاجمة السياسة التركية في حقبتها الجديدة.
هذا الذي تجاهلته –أو زيفته التقارير- كان يخالف واقعا عشته بنفسي لعام ونصف في تركيا، وعاشه معي ملايين المهاجرين والمطاردين من العالم العربي، ولذلك كان الحصول على الحقيقة الموثقة بالأرقام من خلال دراسات ميدانية أمرا عسيرا، حتى أنني استعنت ببعض الأصدقاء الأتراك والعرب العاملين في مجال الإعلام التركي للحصول على دراسات معمقة عن تطور حقوق الإنسان في تركيا، وكانت الإجابة مخيبة للآمال كذلك.
عندئذ ذهبت إلى البحث عن معنى حقوق الإنسان في فكر وفلسفة حزب العدالة والتنمية، وفي أبرز النصوص المكتوبة المعبرة عن هذا التفكير.
إن كل زعماء العالم –حتى أشدهم طغيانا وانتهاكا لحقوق الإنسان- يتغنى بحقوق الإنسان، ويدرج في خطاباته وتصريحاته عبارات محفوظة مكرورة مملولة، لكن ما وجدته في الأدبيات الفكرية للحزب يعبر عن فكر ورؤية وعمق لا عن مجرد زخارف ومحسنات كلامية.
إن العمق الذي يكتبه فيلسوف الحزب ورئيسه الآن، أحمد داود أوغلو، يذهب حتى يحلل البنية التي تحكم الإنسان في النظام السياسي، ولذلك جاءت كتبه كدروس معمقة في نقد النموذج الغربي الذي ظاهره الحفاظ على حقوق الإنسان بينما حقيقته التحكم بالإنسان والتسلط عليه. وإثبات تفوق النموذج الإسلامي الذي سلب الإنسان حق التسلط والتحكم بالإنسان.
ففي كتابه "الفلسفة السياسية" يعزو تناقض النموذجين الغربي والإسلامي إلى أن الأول دائما وفي شتى تصوراته الفلسفية –القديمة والوسيطة والحديثة- الفوارق بين الله والإنسان، فمنح الإنسان سلطة إلهية مما ترتبت عليه آثار بعيدة في النظام السياسي، بينما حرص النموذج الإسلامي على التوحيد الذي يجعل الإنسان مفارقا لله ولا يمكن أن يحوز سلطة إلهية مما كان له آثاره الهائلة في النظام السياسي. ويجدر النظر إلى أن هذا الكتاب صدر عام 1993م، أي قبل وجود حزب العدالة والتنمية بقرابة العقد من الزمن.
وفي كتابه "العالم الإسلامي في مهب التحولات الحضارية"، والذي صدر قبل ميلاد الحزب بثمانية أعوام، يرصد داود أوغلو كيف أنه "في الحضارة الغربية يتولد الاختلال الأخلاقي من اعتمادية المعرفة على مؤسسة السلطة، والتي بدورها تعمل داخل إطار استبدادي بسبب قدرة مراكز القوى على إنتاج معرفة مناسبة كافية لتوليد نظام قيمي ملائم يعمل لمصالحها الذاتية"وفي كتابه الأهم "العمق الاستراتيجي"، والذي يرسم فيه مستقبل الدولة التركية، يؤسس لنظرة نحو الإنسان يقول فيها: "أكثر العناصر حساسية في الانفتاح الاستراتيجي للدولة هو العلاقة المشروعة بين الإرادة السياسية لمركز النظام وبين العنصر البشري المؤهل للمجتمع المدني. وإذا أردنا التعبير عن ذلك بتعبيرات تُستخدم كثيرا في الوقت المعاصر فإنه يمكن وصف هذه العلاقة بنقطة الالتقاء بين "عمق الدولة" و"عمق الأمة". إن الدولة التي لم تصل إلى عمق الأمة، ولم تحقق معه وحدة روحية نابعة عن نظام القيم المشتركة، لن ينتج عنها إلا صورة سيئة للقوة. إن أهم بعد للعلاقة المشروعة بين العنصر البشري والنظام السياسي هو عنصر الثقة؛ فالدولة التي لا تثق بعنصرها البشري لا يمكنها الانفتاح على آفاق استراتيجية، بحيث تضع أهدافا تكتيكية لتحريك القوى الكامنة للمجتمتع، أو أن تستخدم الوسائل المناسبة لهذه الأهداف في التوقيت الصحيح والمناسب"هذه الرؤية العميقة لجوهر حقوق الإنسان ومدى توفرها في بيئة النظام السياسي القائمة، موجودة أيضا منذ قديم عند مؤسس الحزب وزعيمه رجب طيب أردوغان، ففي كلمته التي ألقاها في ختام مؤتمر الديمقراطية (1997م) نظَّر لضرورة أن يضيف المجتمع "أحكام قِيَمه ومعتقداته وعاداته وتقاليده باعتبارها خميرة الثقافة السياسية لهذه التجربة الديمقراطية"، وعندئذ تخرج الديمقراطية من كونها ثرثرة نخبوية بل ووسيلة من وسائل الاستبداد والتسلط النخبوي على المجتمع لتكون روحا حقيقية يؤديها المجتمع كواجبات يومية، ويغذي بها قناعاته الثقافيةنحن هنا أمام تحليل أعمق لمسألة حقوق الإنسان، إنه في جوهره نقد للنموذج الغربي الذي يصطنع شكلا آخر من العبودية والتحكم ثم يلبسها ثوب الحرية ولافتة الديمقراطية وعنوان الانتخابات، وهو نقدٌ يُبنى عليه رؤية أخرى مفادها علاقة صحيحة سوية بين الدولة والأمة، أو بين "عمق الدولة وعمق الأمة" بتعبير داود أوغلو. وهذا المعنى يتردد كثيرا في خطابات وكلمات أردوغان، لكننا نكتفي هنا بأقواها في الدلالة:
1. "لا يمكن لدولة إنسانها ضعيف أن تكون قوية"ديار بكر – 24 يونيو 2007
2. "بالنسبة لنا كل إنسان خاص، وكل إنسان غال وقيّم. لكل إنسا الحق في امتلاك الفرص والحقوق التي يستحقها"اجتماع الكتلة البرلمانية – 13 مايو 2008
3. "الإنسان أساس كل شيء. ولذلك يجب أن تصنع السياسة من أجل سعادة الإنسان وراحته، سلامته وطمأنينته"مؤتمر حزب العدالة والتنمية – 3 أكتوبر 2009
4. "الإنسان أولا، ومن ثَمَّ تأتي الدولة. وليست الدولة هي الأولى ليأتي الإنسان بعدها"الاجتماع الاستشاري - 22 نوفمبر 2009
5. "في هذا البلد ستنهار البنية الإقطاعية بالتأكيد، ويجب عليها أن تنهار وأن تنحط، لأننا لا نقبل عبودية الإنسان للإنسان. وخصوصا في قيمنا الحضارية، لا عبودية لدينا لغير الخالق. ولهذا السبب: إن السيادة للأمة دون قيد أو شرط"سيرت – 6 مايو 2005
6. "الحقائق، الحقوق والحريات لا تتغير وفقا للأشخاص. الحقيقة هي حقيقة في كل زمان ومكان"اجتماع رؤساء المقاطعات – 21 مارس 2008
7. "يجب علينا جميعا أن نعلم أننا متساوون كأسنان المشط في القاسم المشترك بيننا وهو الإنسانية، سواء منا الشرقي والغربي، المسلم والمسيحي، المتدين والعلماني، الغني والفقير، الأبيض والأسود"أمريكا – 7 ديسمبر 2009
بقيت نقطة، وقد أجلتها إلى نهاية الورقة لأنها ذات دلالة في منهج التعامل الغربي مع حقوق الإنسان في تركيا، وهي: القضية الكردية.
إن القضية الكردية حاضرة في كل دراسة أو تقرير عن الحالة التركية، وكثيرا ما حضرت في الماضي من بوابة حقوق الإنسان، وبغير شك فإن الأكراد عانوا كثيرا لنحو قرن من الزمن، وكانوا من الفئات التي سحقتها السياسات القديمة، إلا أن السياسات الجديدة مثلت تحولا كبيرا في التعامل مع الملف الكردي، غير أن التقارير الحقوقية لا تأبه كثيرا لما تحقق وتركز على ما لم يتحقق بعد، وبالعموم، فإن الدراسات الغربية عن تركيا تنظر إلى القضية الكردية كمدخل لعدم استقرار تركيا لا كمدخل لاستقرارها بتعديل الأوضاع السيئة الموروثة. ولذلك فهي تمر على التحسن بعبارة أو بضع عبارة، بينما تفرد باقي الصفحات لرصد المخالفات مع مساحة من التعنت والتعسف ظاهرة وواضحة.إن مسألة حقوق الإنسان في تركيا هي من الحقائق الواضحة التي يعد البحث عن أدلة وجودها تعسف، كقول الشاعر:وليس يصح في الأذهان شيء .. إذا احتاج النهار إلى دليلأو كقول الآخر:فقد تنكر العين نور الشمس من رمد .. وينكر الفم طعم الماء من سقم
فالدليل هو ملايين المهاجرين المتدفقين على تركيا من سائر أنحاء العالم الإسلامي، فكلٌ منهم دليلٌ على الواقع، فضلا عما لقيه هؤلاء من ضيافة وحسن ترحاب من إخوانهم الأتراك، وليس يعرف طعم الأمن إلا من ذاق الخوف. والحق أن منح الخائفين الأمان لا يقل بحال عن منح الجائعين الطعام ومنح الظامئين الشراب، بل لربما يزيد، إذ جوهر تميز الإنسان عن الحيوان هو شعوره بهذا الأمن الذي يعيد إليه شعوره بإنسانيته التي ما هاجر وترك بلده إلا لأنها سُحقِت أو كادت تُسْحق وتموت!
ولهذا أردد مع جميع إخواني: شكرا تركيا..
نشر في تركيا بوست
العالم الإسلامي في مهب التحولات الحضارية ص130. العمق الاستراتيجي ص58. حسين بسلي وعمر أوزباي: رجب طيب أردوغان.. قصة زعيم ص231. المصدر السابق ص241.
Published on April 26, 2016 12:23
April 23, 2016
رفع الملام عن المماليك العظام
يثير غيظي كثيرا أن أجد من يصف العسكر الحاليين بالمماليك في الزمن القديم، رغم أني أعذر صاحب هذا التشبيه وأتفهم أن حركة التجهيل بتاريخنا وتشويهه قد تدفع إلى أكثر من هذا، ذلك أن المماليك بالنسبة إلى عسكر هذا العصر كالجنة بالنسبة إلى الجحيم، كالفارق بين العزة والذلة، بين المجد والهزائم، بين النور والظلام.
أينما وجهنا وجهنا في تاريخ المماليك لمقارنته بأحوال عصرنا ارتد إلينا البصر والعقل وهو حسير، ففي كل مجال لا مجال للمقارنة، وهاك بعض إشارات سريعة:
1. حدود البلادكان المماليك يحكمون مصر والشام والحجاز وأجزاء واسعة من ليبيا ونصف السودان وأحيانا اليمن وأحيانا جزءا من شمال العراق، بل وفي آخر عصورهم حكموا قبرص وكادوا يحكمون جزيرة رودس في البحر المتوسط، حتى ليقول الجغرافي الفذ والمؤرخ ابن فضل الله العمري في وصفها "هي مملكة كبيرة، وأموالها كثيرة، وقاعدة الملك بها قلعة الجبل (قلعة صلاح الدين) ثم دمشق وهي من أجل ممالك الأرض لما حوت من الجهات المعظمة، والأرض المقدسة، والجهات والمساجد التي هي على التقوى مؤسسة، بها المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها وقبور الأنبياء صلوات الله عليهم والطور والنيل والفرات"أما عسكر مصر الآن فقد استلموا مصر والسودان وغزة ثم جاءتهم سوريا تسعى، ففصلوا السودان وأسلموا غزة للصهاينة وتركوا سيناء، وها هم أولاء بعد ستين سنة يواصلون التفريط والتقطيع والتقزيم في حدود البلاد!!
2. الولاء للأمةأقسى المؤرخين حكما على المماليك وبغضا لهم لا يجرؤ على مجرد التفكير في اتهام ولاء المماليك لأمة الإسلام، حتى ولو في أضعف حالاتهم وأسوأها، وليس في تاريخ المماليك هزيمة أو اتفاقية أو هدنة إلا وتفسر في ظل موازين القوة والسياسة والتدبير ولم يفكر مؤرخ في أن يبحث لها عن أصل خيانة.
أما عسكرنا الآن فلم يأت بهم سوى الاحتلال ولا ولاء لهم سوى للعدو الأجنبي، بداية من انقلاب يوليو الذي صارت تدابيره الأمريكية منشورة بالوثائق وبمذكرات صانعيه من الأجانب وباعترافات المنفذين من المصريين، وانتهاءا بعصرنا هذا الذي هو عصر الاعترافات والتسريبات والذي لا يخجل فيه زعماء العساكر أن يتحدثوا عن فخرهم بكونهم جزءا من الأمن القومي الأمريكي، ولا يتردد زعماء العدو في إظهار فرحهم بالاستثمار في الجيش المصري المطيع ولا في تنسيقاته غير المسبوقة في مجال مكافحة الإرهاب! إن ولاءهم للأجانب ليس محل شكٍّ، بل هو عين اليقين، حتى إن تفسيرات أصولهم اليهودية تروج وتجد قبولا عاما لدى الناس بل ولدى كثير من الباحثين!!
ولم يُنسب إلى المماليك كفر، بل كان العلماء يجاهدون تحت رايتهم وكانت لهم مكانة في دولتهم، ولم يفتحوا البلاد للأجانب فيكون لهم فيها نفوذ واسع أو ممالك مصغرة محمية، أما عساكرنا الآن فيختلف الناس في إسلامهم، ولا يجدون سبيلا أصلا ليجاهدوا عدوا تحت رايتهم، والعلماء في عصرهم عند أحط منزلة إن لم يكونوا في الزنازين أو فوق المشانق، والبلاد في عصرهم مفتوحة للأجانب بل هم السادة الحقيقيون الذين لا تردُّ لهم كلمة.
3. الحرب والجهادكانت مأثرة المماليك العظمى هي حملهم لواء الجهاد، وكسرهم عاصفة المغول العاتية التي اجتاحت آسيا منذ الصين حتى وصلت البحر المتوسط، ثم انساحت في الشمال حتى اخترقت شرق أوروبا، لكنها توقفت في الجنوب عند سواحل البحر المتوسط على يد السلطان المملوكي سيف الدين قطز. ثم استكمل بيبرس وقلاوون وأبناؤه الجهاد من بعدهم حتى انتهى خطر المغول، ثم بدأوا في تصفية الوجود الصليبي في الساحل الشامي حتى قضوا تماما على بقايا الحملات الصليبية، ثم هاجموا وكر الهجمات الصليبية في قبرص حتى حرروها ثم هددوا الوكر الثاني في جزيرة رودس. وتاريخ المماليك حافل بالجهاد وبأسماء السلاطين المجاهدين: قطز، بيبرس، سيف الدين قلاوون، المنصور بن قلاوون، الأشرف خليل، الأشرف برسباي، سيف الدين جقمق.
لقد تولى المماليك حكم البلاد وهي تعاني تهديد الصليبيين والمغول ثم تركوها مسلمة مؤمنة وهُزِموا أمام العثمانيين المسلمين، تولوها والبحر المتوسط يسيطر عليه الصليبيون ثم تركوها وهم سادة البحر المتوسط وأصحاب أقوى أسطول بحري في شرقه يستمد قوته من موانئ طرابلس ودمياط والإسكندرية، وكانت جيوشهم أحسن الجيوش والنظم حتى ليقول المؤرخ العباسي الصفدي في فضائل مصر: "فمن ذلك أنّ ملكها أكبر الملوك قدرا، وأعظمهم منزلة، وجميع ملوك البرّ والبحر يخافونه، ويهادونه، ويهادنونه، لحسن جيشه وقوّتهم وخيولهم وعددهم وعددهم، ولا سيما في زماننا هذا، فإنهم أحسن أجناد الدنيا، وعسكره وموكبه أفخر العساكر والمواكب وأحشمهم، وفيهم الصلحاء، والرجال، وفرسان الخيل، ومن مرّت به التجارب، وحضر الحصارات والمصافّات، وقد أيّده الله تعالى بالنصر"أما عساكرنا الآن فليس لهم ولا نصر واحد على عدو من أعداء الأمة، وغاية ما يفرحون به (حرب أكتوبر) إنما هي هزيمة يتبادل أطرافها تحميل بعضهم المسؤولية عنها، وأحسن ما يقال فيها أنها نصف نصر في الأيام الأولى آل إلى هزيمة كاملة وشاملة، وما سوى ذلك فلا تجد حتى نصرا مشكوكا فيه. إلا أنهم يتلقون الهزائم التاريخية، وتستطيع دولة صغيرة أن تبتلع ضعف حجمها في ساعات، وتصدر الأوامر بالانسحاب قبل أن ينشب قتال، ويعرف زعيمهم خبر احتلال بلاده من الوكالات الصحفية التي نقلت البيان الإسرائيلي الرسميانتصاراتهم الوحيدة إنما هي على الشعوب التي يستعملون فيها أنواع الأسلحة، فينصبون لها المجازر والمذابح، ويفتحون لها السجون والمعتقلات، بل هم يتآمرون على حركات المقاومة التي تجاهد العدو، ويحفظون أمن إسرائيل، ولم يفكر الجيش المصري منذ انقلاب يوليو في تهديد إسرائيل، ولعل عسكر الحاضر أول جيوش في التاريخ يكون زوالها خيرا من بقائها، ويكون وجودها سببا في احتلال البلاد وتشريد العباد وضرب حركات المقاومة، بل وتكون الأراضي المحررة وحدها هي التي لم توجد فيها هذه الجيوش (قطاع غزة مثالا)! وتكون عصورهم أسوأ من عصور الاحتلال نفسه!
فأين المماليك من العسكر؟!
لئن اطلع مؤرخو المماليك على عصرنا الآن لهتفوا مع القائل: رب يوم بكيتُ فيه، فلما صِرْتُ في غيره بكيتُ عليه!
على أن هذا ليس كل شيء، بل لا بد أن نقارن أيضا بين حكم المماليك وحكم عساكرنا في مجال الحالة العلمية والآثار العمرانية والمآثر الحضارية، بل وفي المظالم والمفاسد أيضا، فيكون هذا حديثنا في المقال القادم إن شاء الله تعالى.
نشر في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية
ابن فضل الله العمري، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، ط1 (أبو ظبي: المجمع الثقافي، 1423هـ)، 3/415. ابن فضل الله العمري، مسالك الأبصار، مرجع سابق 3/28. العباسي الصفدي، نزهة المالك والمملوك في مختصر سيرة من ولي مصر من الملوك، تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري، ط1 (بيروت: المكتبة العصرية، 2003م)، ص33. بشهادة هيكل، لم يعرف عبد الناصر دخول إسرائيل في حرب 1956 إلى بلاده إلا من برقية وكالة يونايتد برس التي نقلت البيان الرسمي الإسرائيلي من تل أبيب، وكان في حفل عيد ميلاد ابنه عبد الحميد ثم انسل هو وعبد الحكيم عامر إلى مكتب عبد الناصر، وحاول عبد الحكيم الاتصال بمقر القيادة العسكرية ولكن لم يكن لديها خبر لأن وحدات سيناء لم تبلغ عن شيء. انظر: محمد حسنين هيكل، قصة السويس، ط2 (بيروت: شركة المطبوعات، 1982م.) ص227.
أينما وجهنا وجهنا في تاريخ المماليك لمقارنته بأحوال عصرنا ارتد إلينا البصر والعقل وهو حسير، ففي كل مجال لا مجال للمقارنة، وهاك بعض إشارات سريعة:
1. حدود البلادكان المماليك يحكمون مصر والشام والحجاز وأجزاء واسعة من ليبيا ونصف السودان وأحيانا اليمن وأحيانا جزءا من شمال العراق، بل وفي آخر عصورهم حكموا قبرص وكادوا يحكمون جزيرة رودس في البحر المتوسط، حتى ليقول الجغرافي الفذ والمؤرخ ابن فضل الله العمري في وصفها "هي مملكة كبيرة، وأموالها كثيرة، وقاعدة الملك بها قلعة الجبل (قلعة صلاح الدين) ثم دمشق وهي من أجل ممالك الأرض لما حوت من الجهات المعظمة، والأرض المقدسة، والجهات والمساجد التي هي على التقوى مؤسسة، بها المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها وقبور الأنبياء صلوات الله عليهم والطور والنيل والفرات"أما عسكر مصر الآن فقد استلموا مصر والسودان وغزة ثم جاءتهم سوريا تسعى، ففصلوا السودان وأسلموا غزة للصهاينة وتركوا سيناء، وها هم أولاء بعد ستين سنة يواصلون التفريط والتقطيع والتقزيم في حدود البلاد!!
2. الولاء للأمةأقسى المؤرخين حكما على المماليك وبغضا لهم لا يجرؤ على مجرد التفكير في اتهام ولاء المماليك لأمة الإسلام، حتى ولو في أضعف حالاتهم وأسوأها، وليس في تاريخ المماليك هزيمة أو اتفاقية أو هدنة إلا وتفسر في ظل موازين القوة والسياسة والتدبير ولم يفكر مؤرخ في أن يبحث لها عن أصل خيانة.
أما عسكرنا الآن فلم يأت بهم سوى الاحتلال ولا ولاء لهم سوى للعدو الأجنبي، بداية من انقلاب يوليو الذي صارت تدابيره الأمريكية منشورة بالوثائق وبمذكرات صانعيه من الأجانب وباعترافات المنفذين من المصريين، وانتهاءا بعصرنا هذا الذي هو عصر الاعترافات والتسريبات والذي لا يخجل فيه زعماء العساكر أن يتحدثوا عن فخرهم بكونهم جزءا من الأمن القومي الأمريكي، ولا يتردد زعماء العدو في إظهار فرحهم بالاستثمار في الجيش المصري المطيع ولا في تنسيقاته غير المسبوقة في مجال مكافحة الإرهاب! إن ولاءهم للأجانب ليس محل شكٍّ، بل هو عين اليقين، حتى إن تفسيرات أصولهم اليهودية تروج وتجد قبولا عاما لدى الناس بل ولدى كثير من الباحثين!!
ولم يُنسب إلى المماليك كفر، بل كان العلماء يجاهدون تحت رايتهم وكانت لهم مكانة في دولتهم، ولم يفتحوا البلاد للأجانب فيكون لهم فيها نفوذ واسع أو ممالك مصغرة محمية، أما عساكرنا الآن فيختلف الناس في إسلامهم، ولا يجدون سبيلا أصلا ليجاهدوا عدوا تحت رايتهم، والعلماء في عصرهم عند أحط منزلة إن لم يكونوا في الزنازين أو فوق المشانق، والبلاد في عصرهم مفتوحة للأجانب بل هم السادة الحقيقيون الذين لا تردُّ لهم كلمة.
3. الحرب والجهادكانت مأثرة المماليك العظمى هي حملهم لواء الجهاد، وكسرهم عاصفة المغول العاتية التي اجتاحت آسيا منذ الصين حتى وصلت البحر المتوسط، ثم انساحت في الشمال حتى اخترقت شرق أوروبا، لكنها توقفت في الجنوب عند سواحل البحر المتوسط على يد السلطان المملوكي سيف الدين قطز. ثم استكمل بيبرس وقلاوون وأبناؤه الجهاد من بعدهم حتى انتهى خطر المغول، ثم بدأوا في تصفية الوجود الصليبي في الساحل الشامي حتى قضوا تماما على بقايا الحملات الصليبية، ثم هاجموا وكر الهجمات الصليبية في قبرص حتى حرروها ثم هددوا الوكر الثاني في جزيرة رودس. وتاريخ المماليك حافل بالجهاد وبأسماء السلاطين المجاهدين: قطز، بيبرس، سيف الدين قلاوون، المنصور بن قلاوون، الأشرف خليل، الأشرف برسباي، سيف الدين جقمق.
لقد تولى المماليك حكم البلاد وهي تعاني تهديد الصليبيين والمغول ثم تركوها مسلمة مؤمنة وهُزِموا أمام العثمانيين المسلمين، تولوها والبحر المتوسط يسيطر عليه الصليبيون ثم تركوها وهم سادة البحر المتوسط وأصحاب أقوى أسطول بحري في شرقه يستمد قوته من موانئ طرابلس ودمياط والإسكندرية، وكانت جيوشهم أحسن الجيوش والنظم حتى ليقول المؤرخ العباسي الصفدي في فضائل مصر: "فمن ذلك أنّ ملكها أكبر الملوك قدرا، وأعظمهم منزلة، وجميع ملوك البرّ والبحر يخافونه، ويهادونه، ويهادنونه، لحسن جيشه وقوّتهم وخيولهم وعددهم وعددهم، ولا سيما في زماننا هذا، فإنهم أحسن أجناد الدنيا، وعسكره وموكبه أفخر العساكر والمواكب وأحشمهم، وفيهم الصلحاء، والرجال، وفرسان الخيل، ومن مرّت به التجارب، وحضر الحصارات والمصافّات، وقد أيّده الله تعالى بالنصر"أما عساكرنا الآن فليس لهم ولا نصر واحد على عدو من أعداء الأمة، وغاية ما يفرحون به (حرب أكتوبر) إنما هي هزيمة يتبادل أطرافها تحميل بعضهم المسؤولية عنها، وأحسن ما يقال فيها أنها نصف نصر في الأيام الأولى آل إلى هزيمة كاملة وشاملة، وما سوى ذلك فلا تجد حتى نصرا مشكوكا فيه. إلا أنهم يتلقون الهزائم التاريخية، وتستطيع دولة صغيرة أن تبتلع ضعف حجمها في ساعات، وتصدر الأوامر بالانسحاب قبل أن ينشب قتال، ويعرف زعيمهم خبر احتلال بلاده من الوكالات الصحفية التي نقلت البيان الإسرائيلي الرسميانتصاراتهم الوحيدة إنما هي على الشعوب التي يستعملون فيها أنواع الأسلحة، فينصبون لها المجازر والمذابح، ويفتحون لها السجون والمعتقلات، بل هم يتآمرون على حركات المقاومة التي تجاهد العدو، ويحفظون أمن إسرائيل، ولم يفكر الجيش المصري منذ انقلاب يوليو في تهديد إسرائيل، ولعل عسكر الحاضر أول جيوش في التاريخ يكون زوالها خيرا من بقائها، ويكون وجودها سببا في احتلال البلاد وتشريد العباد وضرب حركات المقاومة، بل وتكون الأراضي المحررة وحدها هي التي لم توجد فيها هذه الجيوش (قطاع غزة مثالا)! وتكون عصورهم أسوأ من عصور الاحتلال نفسه!
فأين المماليك من العسكر؟!
لئن اطلع مؤرخو المماليك على عصرنا الآن لهتفوا مع القائل: رب يوم بكيتُ فيه، فلما صِرْتُ في غيره بكيتُ عليه!
على أن هذا ليس كل شيء، بل لا بد أن نقارن أيضا بين حكم المماليك وحكم عساكرنا في مجال الحالة العلمية والآثار العمرانية والمآثر الحضارية، بل وفي المظالم والمفاسد أيضا، فيكون هذا حديثنا في المقال القادم إن شاء الله تعالى.
نشر في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية
ابن فضل الله العمري، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، ط1 (أبو ظبي: المجمع الثقافي، 1423هـ)، 3/415. ابن فضل الله العمري، مسالك الأبصار، مرجع سابق 3/28. العباسي الصفدي، نزهة المالك والمملوك في مختصر سيرة من ولي مصر من الملوك، تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري، ط1 (بيروت: المكتبة العصرية، 2003م)، ص33. بشهادة هيكل، لم يعرف عبد الناصر دخول إسرائيل في حرب 1956 إلى بلاده إلا من برقية وكالة يونايتد برس التي نقلت البيان الرسمي الإسرائيلي من تل أبيب، وكان في حفل عيد ميلاد ابنه عبد الحميد ثم انسل هو وعبد الحكيم عامر إلى مكتب عبد الناصر، وحاول عبد الحكيم الاتصال بمقر القيادة العسكرية ولكن لم يكن لديها خبر لأن وحدات سيناء لم تبلغ عن شيء. انظر: محمد حسنين هيكل، قصة السويس، ط2 (بيروت: شركة المطبوعات، 1982م.) ص227.
Published on April 23, 2016 15:44



