عبـــــــدالله خلــــــــيفة's Blog: https://isaalbuflasablog.wordpress.com , page 50
February 14, 2023
عبÙÙÙÙÙÙÙداÙÙÙ Ø®ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙØ©:أسئÙØ© اÙص٠ت ÙاÙÙÙر Ù٠اÙاستÙاÙØ© عÙ٠أÙجاع اÙتارÙØ®!
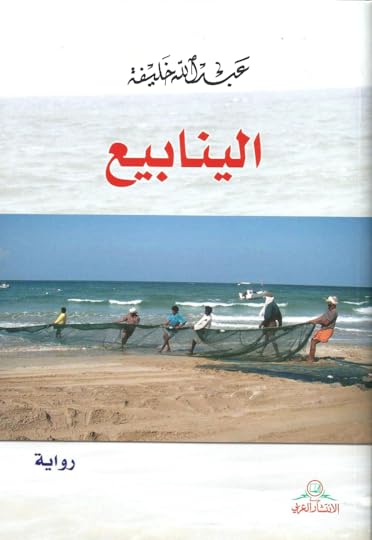
ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ
* Ùاتب ٠٠اÙبØرÙÙ
عبÙÙÙÙÙÙÙداÙÙÙ Ø®ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙØ©:أسئÙØ© اÙص٠ت ÙاÙÙÙر Ù٠اÙاستÙاÙØ© عÙ٠أÙجاع اÙتارÙØ®!
عبـــــــدالله خلــــــــيفة:أسئلة الصمت والقهر في الاستفاقة على أوجاع التاريخ!
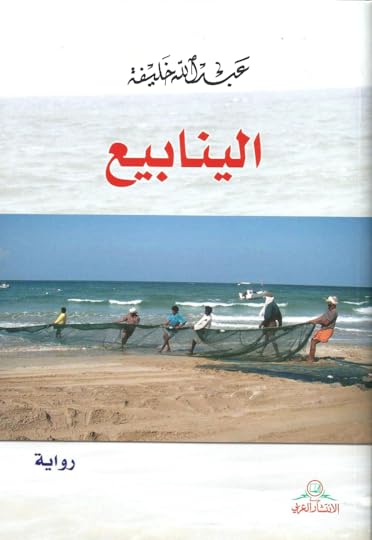
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* كاتب من البحرين
عبـــــــدالله خلــــــــيفة:أسئلة الصمت والقهر في الاستفاقة على أوجاع التاريخ!
February 13, 2023
اÙÙسار Ù٠اÙبØرÙÙ ÙاÙاÙتÙازÙØ©
 عبÙÙÙÙÙÙÙداÙÙÙ Ø®ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙØ©
عبÙÙÙÙÙÙÙداÙÙÙ Ø®ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙØ©ââââââÙاتب ÙرÙائÙ
ððððððð ððððððð
ðððððð ðð ððððððð ððð ðððððð
21.10.2014 | 1.3.1948
#اÙÙ Ùبر_اÙتÙد٠Ù
اÙبÙرجÙازÙÙ٠اÙصغار اÙاÙتÙازÙÙÙ
Ù٠أساس٠اÙعÙارة ÙاÙج٠بزة ÙاÙاÙتÙازÙØ© ÙتخرÙب اÙتطÙØ±Ø Ø§ÙÙ ÙاÙÙÙ٠اÙ٠عاصرÙÙØ ÙÙÙ ÙÙ ÙÙ Øزب Ù ÙÙØ¹Ø ÙÙÙÙ ÙÙ ÙÙ Ø«Ùرة ÙصÙØ¨Ø ÙÙÙÙ ÙÙ ÙÙ Ø«Ùرة ٠ضادة ÙصÙØ¨Ø ÙÙ٠٠ع اÙÙÙراء ÙاÙأغÙÙØ§Ø¡Ø ÙÙ٠٠ع اÙÙسار ÙاÙÙÙ ÙÙØ ÙÙ٠٠ع اÙدÙÙÙÙÙ Ù٠ع اÙÙ ÙØدÙÙØ ÙÙ٠٠ع اÙØÙÙ ÙأعدائÙØ ÙÙ٠٠ع اÙØÙÙÙØ© ÙاÙباطÙØ ÙÙÙ٠ا شئت ÙاÙÙ Ù٠أ٠تدÙع!
اÙÙ Ù٠أ٠تغذÙÙ٠باÙØ£Ù ÙاÙØ Ø£Ù Ø¨Ø§ÙØ´Ùرة ÙاÙ٠جا٠ÙØ© ÙاÙÙÙØ®Ø ÙاÙØ£Ù Ùا٠ÙاÙجÙائز ÙاÙعطاÙا ÙاÙÙراس٠تغذ٠اÙÙشاط اÙÙÙر٠ÙدÙÙÙ Ø ØªØ¬Ø¹Ù Ù ÙÙÙاتÙ٠اÙعÙÙÙØ© Ùجأة تتÙت٠باÙاÙتشاÙات اÙ٠بÙØ±Ø©Ø ÙاÙØ«Ùاجات اÙÙ ÙÙئة باÙÙØÙÙ ÙاÙسÙارات ÙاÙأراضÙ.
Ù٠٠تخÙÙÙÙ Ù٠اÙÙÙر ÙØ¥Ùتاج اÙÙØªØ¨Ø ÙتاجÙ٠٠زÙÙØ ÙÙس ÙÙ٠أ٠تØÙÙÙ ÙÙصراعات اÙطبÙÙØ© اÙÙ Ø¹Ø§ØµØ±Ø©Ø ÙØ£ÙÙÙ ÙرÙضÙ٠أ٠ÙتخذÙا Ù ÙÙÙا٠بÙ٠اÙÙÙراء ÙاÙأغÙÙØ§Ø¡Ø Ø¨Ù٠اÙع٠ا٠ÙاÙØ¥Ùطاع ÙاÙبرجÙازÙØ©Ø Ø¹ÙارÙÙ Ø¬Ø¯Ø¯Ø Ø«Ù ÙتشدÙÙ٠باÙÙØ«Ùر ٠ع اÙخراÙات اÙØدÙثة ÙاÙÙدÙÙ Ø©Ø ÙÙ٠جبÙاء اÙتÙازÙÙÙ ÙÙت٠ÙÙ ÙØ«Ùرا٠بجÙÙبÙÙ Ø ÙÙÙس باÙدÙاع ع٠اÙØÙÙÙØ© ÙاÙÙاس. Ù Ù ÙÙا Ùا Ùتع٠ÙÙÙ Ù٠اÙ٠عار٠اÙاجت٠اعÙØ© ÙاÙسÙاسÙØ©Ø ÙÙÙÙ ÙÙاصÙÙÙ Ø°ÙÙ ÙÙÙÙا Ùطع أرزاÙÙ٠اÙÙÙÙرةØ
Ùتجد دائ٠ا٠أ٠ÙÙ٠اتÙ٠تÙصب Ù٠اتجا٠٠عÙÙ ÙØÙØ¯Ø Ù Ø³ØªÙ Ø± أبدÙØ Ùا ÙتØÙÙ ÙÙا ÙتبدÙØ ÙÙØ£ÙÙ٠آÙات ٠٠غÙطة ÙÙائÙات Ù ÙجÙØ©Ø ØªÙرأÙÙ ÙØ£Ùت Ù٠اÙبÙت دÙ٠اÙØاجة ÙÙÙØ±Ø§Ø¡Ø©Ø ÙخاÙÙ٠٠٠أ٠تÙØ¬Ù Ø¢Ø®Ø±Ø Ù Ø¯Ø§Ø±Ù٠إÙÙترÙÙÙا٠٠٠أÙ٠ار صÙاعÙØ© Ù٠٠٠خاÙر ÙÙÙÙØ©Ø ÙØ£ÙÙÙ ÙÙضعÙا عÙ٠سÙ٠اÙØدÙØ¯Ø Ùا ÙÙتÙتÙÙ ÙÙ ÙØ© Ø£Ù ÙØ³Ø±Ø©Ø ÙداÙعÙ٠ع٠ØÙÙÙ Ø§ØªØ Ø£Ù Ø¹Ù Ø§ØªØ¬Ø§Ùات سائدة باÙشعرة Ù Ù٠ا ÙاÙرÙا أ٠أدعÙØ§Ø ÙÙÙ٠اÙبÙÙÙ ÙاÙ٠عاشات ÙاÙÙراس٠ÙاÙجÙائز ÙاÙÙ ÙاÙع ÙاÙÙ Ùاصب ÙاÙبÙØ§Ø¹Ø§ØªØ ÙÙ٠أÙÙار ٠دÙÙع ÙÙا سÙÙاÙØ ÙÙÙ Ùتابات ٠أجÙرة Ù Ùد٠اÙØ ÙسخاÙات ÙاÙÙع ÙÙÙا ÙضررÙا ÙØ«Ùر عÙ٠اÙعÙÙÙ.
بÙ٠عشÙØ© ÙضØاÙا ÙتÙÙب اÙبرجÙازÙÙ٠اÙصغار اÙاÙتÙازÙÙÙØ Ù Ù Ø§ÙعÙ٠اÙÙØ© ÙاÙØ«Ùرة اÙتÙد٠ÙØ© Ø¥Ù٠٠ساÙدة اÙتخرÙ٠اÙدÙÙÙØ Ø§ÙتخرÙ٠اÙدÙÙÙ ÙاÙشعÙذة ÙÙÙس Ø¥Ù٠تصØÙØ Ùذ٠اÙÙ ÙاÙÙÙ ÙØ¥Ùتاج عÙÙاÙÙØ© دÙÙÙØ© Ù ÙÙدة Ù Ù٠ا ÙاÙت ÙØ°Ù٠٠صائبÙØ§Ø ÙÙÙتÙÙÙ٠٠٠اÙدعÙØ© ÙÙØ«Ùرة اÙع٠اÙÙØ© ÙاÙتÙاضات اÙÙادØÙ٠إÙ٠خد٠ة اÙÙ ÙاÙÙ ÙاÙ٠جر٠Ù٠اÙ٠طاردÙ٠دÙÙÙاÙÙØ ÙتبرÙر اÙأرÙاب بÙ٠اشÙاÙÙ ÙÙ٠دÙ٠أ٠تصÙب ØصاÙاتÙÙ ÙعائÙاتÙ٠اÙÙ Ùدسة Ø£Ù Ø¶Ø±Ø±Ø ÙÙع٠ÙÙÙ Ùخد٠ة اÙطائÙÙÙÙ ÙأجÙزة اÙاستخبارات ÙÙدÙ٠اÙÙÙÙ ÙØ© ÙاÙدÙÙÙØ© اÙدÙتاتÙرÙØ©Ø (Ùا Ø¥ÙÙÙ ÙÙÙ ÙبÙع ÙؤÙاء اÙÙاس٠أÙÙسÙÙ٠بÙ٠عشÙØ© ÙضØاÙا Ø!).
ÙاÙأدباء ÙاÙÙا٠بدعÙÙ ÙÙÙ ÙصÙبÙ٠اÙÙبÙر اÙÙاÙر Ù Ù Ùذ٠اÙاÙتÙازÙØ©Ø ÙÙد ÙÙا ÙÙتظر ÙضاÙÙÙ ÙÙضØÙÙ ÙÙاستغÙا٠ÙجÙب اÙع٠اÙØ© اÙأجÙبÙØ© اÙرثة ÙاÙتصد٠ÙÙدÙتاتÙرÙات ÙØÙÙ٠ات اÙسرÙØ©Ø ÙÙ ÙصصÙÙ ÙأشعارÙÙ ÙرÙاÙاتÙÙ Ø ÙÙÙÙ Ùا خبر جاء٠ÙÙا Ùشر٠ÙزÙ!
ÙÙÙÙÙ ÙتعÙÙÙ٠أ٠اÙأدب ÙاÙÙ٠سا٠Ùا٠Ùا ÙتÙÙثا٠بÙذا اÙأسÙا٠اÙشعبÙØ ÙØ£ÙÙ٠ا ÙائÙا٠ع٠اÙÙ Ø§Ø¯Ø©Ø Ùع٠اÙج٠ÙÙر اÙبسÙØ· ÙÙ ØدÙدÙØ© إدراÙÙ Ùسذاجة Ù ÙاÙÙÙ ÙØ Ù٠ع Ùذا ÙÙجد Ø£ÙÙ٠٠شغÙÙÙ٠باÙ٠ادة اÙØ°ÙبÙØ© ÙØ«ÙراÙØ Ø®Ø§ØµØ© Ù٠شراء اÙÙÙØات ÙÙسب اÙجÙائز Ùطباعة اÙÙتب ٠جاÙا٠ÙاÙØصÙ٠عÙ٠تذاÙر اÙسÙر ÙØضÙر اÙÙ ÙرجاÙات بأبÙØ©Ø ÙÙÙÙÙÙ٠إ٠ÙÙس ÙÙ٠عÙاÙØ© باÙأجÙر ÙاÙسÙا٠اÙدÙÙÙÙØ© ÙÙ٠٠٠٠ادة صÙÙÙØ© أثÙرÙØ© تضØÙÙØ© خاÙدة Ø¥Ùا إذا اÙØ®Ùضت ٠رتباتÙ٠اÙÙبÙØ±Ø©Ø ÙسÙÙ ÙجأرÙ٠باÙØ´ÙÙÙ ÙØ«ÙراÙØ ÙÙد جÙت أشعارÙÙ ÙÙÙØاتÙÙ ÙÙتباتÙÙ ÙÙد ÙØ£Ùا ع٠Ùضا٠اÙØ´Ø¹Ø¨Ø Ùصارت اÙÙÙÙ Ø© Ù٠اÙØصاÙØ©Ø Ùصار اÙÙ ÙÙ٠تبعا٠Ùأسعار اÙبÙØ±ØµØ©Ø ÙÙ٠أعطÙÙ Ø´Ùئا٠أÙتب Ù٠٠ا ØªØ´Ø§Ø¡Ø Ø«Ù ØµØ§Ø± اÙÙراء٠اÙشعر٠اÙ٠ادة اÙس٠اÙÙØ© اÙت٠٠ÙÙا Ù٠تØÙÙ Ù٠سخاÙاتÙÙ Ùأع٠اÙÙ٠اÙ٠سرØÙØ© ÙاÙÙÙÙØ© ÙبراءتÙ٠٠٠د٠ÙÙسÙ! د٠اÙØ´Ùداء ÙاÙÙ ÙاضÙÙÙ! ÙتجدÙÙ ÙÙرجÙÙ Ù٠اÙÙ Ø³Ø±Ø ÙÙ٠اÙÙتابة ÙÙ٠اÙسÙاسة ÙÙظÙÙ٠أ٠اÙÙراء ÙاÙ٠شاÙدÙ٠جÙÙØ© Ùا ÙعرÙÙ٠٠ا ÙصÙÙا Ø¥ÙÙ٠٠٠إÙØدار Ù٠٠عجز ع٠اÙÙ ÙاÙÙ Ø©! Ù٠إÙادتÙÙ ÙÙ٠اتÙÙ ÙÙÙØاتÙÙ ÙأصÙا٠ÙÙ Ø´Ùئا٠إÙا ٠ا Ù٠عابرØ
ÙÙا ÙÙÙ Ù ÙاطÙÙÙÙ ÙØ£Ùرا٠اÙسؤ اÙآخرÙÙ (اÙدÙÙÙÙÙ) ع٠Ùذا اÙ٠ثا٠(اÙ٠شع)Ø Ø¨Ù ÙÙد سبÙÙÙÙ Ù٠اÙعÙارة ÙاÙÙصب عÙ٠اÙØ³Ø°Ø¬Ø ÙÙؤÙاء تاجرÙا Ù٠اÙدÙÙ ÙÙذ٠٠٠أعظ٠اÙÙØ¨Ø§Ø¦Ø±Ø ÙجعÙÙ٠٠صÙدة ÙØصاÙØ© Ùبئس ٠ا ÙصÙعÙÙ! Ø¥Ùا Ù Ù Ùاض٠جاÙرا٠ÙÙÙا٠٠٠أج٠ØÙÙ٠اÙÙاس Ùا تÙÙ Ù Ù٠اÙØÙ ÙÙÙ Ø© Ùائ٠Ùإذا صار Ùا ÙÙدÙع ÙÙ Ø´ÙØ¡ Ùاص٠طرÙÙÙØ ÙÙÙس ÙضاÙ٠٠تÙÙ٠عÙ٠دخÙ٠اÙرÙÙØ¹Ø Ø£Ù Ø¹Ù٠رئÙس ÙÙرس٠بائس!
اÙبرجÙازÙÙ٠اÙصغار اÙاÙتÙازÙÙÙ ÙÙس ÙÙ٠٠٠٠ا٠ÙبÙر ÙØÙظÙ٠٠٠اÙسؤاÙØ ÙÙا Ù Ù Ù ÙÙ٠٠تجذر ÙرÙعÙ٠ع٠اÙاÙØØ¯Ø§Ø±Ø ÙÙا ٠٠ع٠٠اÙÙÙر ٠ا Ùس٠٠بÙ٠ع٠اÙتسÙÙØ ÙÙا ٠٠ع٠٠اÙدÙ٠٠ا ÙÙأ٠بÙ٠ع٠اÙتجارة ب٠ا ÙÙ Ø«Ù ÙÙ Ùا ÙÙÙدر ب٠اÙ!
خسرÙا اÙÙ ÙÙÙ ÙÙ٠جÙÙر اÙشخصÙØ© ÙتراÙÙ Ùا اÙأخÙاÙ٠اÙرÙÙع ÙÙدرتÙا عÙ٠اÙÙÙ Ù ÙاÙتأصÙÙ ÙاÙتØÙÙÙ ÙاÙبÙاء اÙشا٠خ ÙاÙÙÙد اÙشجاع اÙØ°Ù Ùا ÙØ·Ùب Ù ÙØ£Ùاة ÙÙا رعاÙØ© Ù Ù ÙصÙØµØ ÙÙا تÙدÙر ٠٠اÙØÙÙر ذ٠اÙجا٠ÙاÙ٠اÙ.
اÙتÙازÙة٠اÙتØدÙØ«ÙÙÙ
تعددت عÙاÙات Ùئات اÙبرجÙازÙØ© اÙصغÙرة باÙØ¥Ùطاع ÙÙ٠تعت٠د عÙ٠طبÙعة اÙعصر ÙÙÙ Ø· اÙØ¥Ùتاج. ØÙÙ ÙÙرأ ÙÙÙ ÙتدÙÙر Ùع٠ÙؤÙاء ÙÙتراجعÙ٠٠٠اÙØداثة Ø¥Ù٠اÙÙ ØاÙظة ÙاÙطائÙÙØ© ÙÙا بد Ù Ù Ùراءة Ø«ÙاÙØ© اÙ٠رØÙØ©Ø Ùز٠ÙÙØ© اÙØ¥Ùطاع اÙسÙاس٠ÙØÙ٠تÙÙ٠اÙدÙÙة٠اÙعربÙØ© Ø£ÙÙÙ Ù Ù ÙÙÙØ° رجا٠اÙدÙÙ Ù Ù Ø«Ù٠اÙØ¥Ùطاع اÙدÙÙÙØ ÙÙا تÙÙÙ ÙدÙÙا ٠٠اÙÙ Ùارد ٠ا ÙÙÙÙ Ùشراء Ø°Ù Ù ÙؤÙاء ÙØÙ٠تÙÙدÙا ÙÙجأÙÙ ÙغÙرÙا.
إ٠تÙج٠٠ج٠Ùعات Ù- Ùا ÙÙÙ٠تÙارات ÙÙرÙØ© سÙاسÙØ©- Ø¥Ù٠اÙÙÙØ® Ù٠اÙج٠اعات اÙدÙÙÙØ© اÙطائÙÙØ© بشÙÙ ÙبÙر ث٠اÙتراخ٠ع٠ذÙ٠بسبب ÙÙØ© اÙدÙع اÙ٠اÙÙ ÙÙا ٠٠اÙج٠اعات اÙدÙÙÙØ© اÙت٠صارت Ù٠اÙÙ Ù Ù٠اÙÙبÙر ÙÙØ¶Ø Ø·Ø¨Ùعة اÙتدخÙات اÙسÙاسÙØ© اÙÙÙÙÙØ© ÙاÙأجÙبÙØ© ÙØر٠Ùذ٠اÙج٠اعات ع٠اÙتجذر Ù٠أرضÙا ÙاÙتغÙغ٠Ù٠تØÙÙÙÙ Ùدرس٠ÙÙتابة بØÙØ« Ùبرا٠ج ٠ؤصÙØ© ÙÙضاÙاÙ.
Ø¥Ù Ùذا اÙÙع٠اÙÙ Ø³Ø·Ø Ø§ÙتجÙÙÙÙ ÙÙÙد اÙÙاس ÙÙÙÙØ§Ø±Ø«Ø Ø³Ùاء Ù٠اختÙاراتÙ٠اÙتشرÙعÙØ© Ø£Ù ÙÙ ÙضاÙاتÙ٠اÙÙÙÙ ÙØ© اÙ٠ج٠دة ع٠Ù٠اÙØ ÙÙÙذا Ùإ٠٠بدأÙØ© اÙتØدÙØ«ÙÙÙ ÙتÙجÙÙÙ ÙÙشر اÙØ®Ùارات اÙÙÙرÙØ© اÙÙØ·ÙÙØ© ÙاÙدÙÙ ÙراطÙØ© ÙاÙتÙد٠ÙØ© غدت Ø·Ù٠اÙÙجاة.
أثبتت اÙ٠رØÙØ© خطÙرة اÙاÙتÙازÙØ© ÙاÙÙÙارث اÙت٠سببتÙا ÙاÙØصاد اÙ٠اÙ٠اÙشخص٠Ùبعض ÙÙاداتÙا اÙت٠Ùعبت عÙ٠اÙØبا٠Ùاختارت اÙدÙائر اÙرس٠ÙØ© ÙعطائÙا ÙÙاÙت ٠ع اÙطائÙÙÙ٠ساعة صعÙدÙÙ Ù٠ع اÙ٠ا٠ÙاÙÙÙÙØ° ساعة ÙÙتÙ.
ÙÙجد Ù٠اÙتÙاÙاتÙا اÙجغراÙÙØ© ÙاÙØÙاتÙØ© ÙاÙع٠ÙÙØ© غÙابا٠ÙØ£Ù Ùع٠٠تجذر Ù٠ا Ù٠سÙ٠شعارات زائÙØ© ÙتØبÙØ° اÙاشتراÙÙØ© ÙاÙدعÙØ© Ø¥ÙÙÙا ÙأصØاب اÙدعÙØ© ÙÙ Ù٠ج٠ع اÙ٠اÙ!
Ù٠ا تزا٠ÙÙاعد Ùذ٠اÙج٠اعات غÙر Ùادرة عÙ٠اÙÙÙد Ùطرد اÙاÙتÙازÙÙ٠٠٠صÙÙÙÙا Ù٠ا تزا٠تعط٠ÙÙذ٠اÙÙجÙ٠اÙ٠تراÙصة عÙ٠اÙØبا٠اÙسÙاسÙØ© Ù ÙاÙا٠٠Ù٠اÙ.
ÙÙÙذا Ùر٠اÙأشÙاÙ٠اÙاجت٠اعÙØ© ٠٠اÙبرجÙازÙØ© اÙصغÙرة ÙÙ٠تتذبذب Øسب تدÙ٠اÙبØر اÙاجت٠اعÙØ ÙØÙ٠تÙÙ٠اÙدÙÙØ© اÙعربÙØ© ÙÙÙØ© Ùذات Ù Ùارد Ùتجز٠ÙÙ٠اÙعطاء ÙؤÙدÙ٠اÙÙ٠اÙتØدÙث٠٠٠اÙتطÙØ±Ø ÙÙعادÙ٠اÙÙ Ùجات اÙدÙÙÙØ©Ø Øت٠إذا بدأت اÙÙ ÙازÙ٠تخت٠ÙضعÙت Ù Ùارد٠اÙدÙÙØ© اÙعربÙØ© ÙتÙاÙ٠ت أز٠اتÙÙا اÙتشر اÙجراد٠اÙطائÙÙ ÙØ£ÙÙ٠اÙØÙÙÙÙ ÙÙØ´Ùع٠اÙÙØØ·Ù Ù٠اÙØÙاة ÙراØت Ùذ٠اÙÙئات٠ÙÙسÙا تصعد ÙاÙطات ٠ختÙÙØ©Ø ØªØ¤Ùد اÙعÙدة ÙÙÙراء ÙÙد٠اÙتطÙر اÙÙØ·ÙÙ ÙاÙØداثة ÙاÙعÙ٠اÙÙØ©.
Ùإذا Ùا٠اÙج٠اعات اÙدÙÙÙØ© اÙÙدÙÙ Ø© Ùد ÙÙÙت اÙج٠اÙÙر٠اÙعربÙØ© ÙÙس٠تÙا Ø¥ÙÙ ÙسÙÙساء ÙØ£ÙÙتÙا ÙÙسÙطرات اÙأجÙبÙØ© ÙÙذا ٠ا ÙÙÙ٠ب٠اÙطائÙÙÙ٠اÙ٠عاصرÙÙ ÙتÙابعÙ٠٠٠اÙبرجÙازÙÙ٠اÙصغار اÙاÙتÙازÙÙ٠اÙ٠تذبذبÙÙØ Ø§ÙØ°ÙÙ ÙجدÙاÙÙ Ù٠٠رØÙØ© ÙرÙعÙ٠شعارات اÙØ«Ùرات اÙع٠اÙÙØ© اÙØ٠راء ÙاÙبÙدÙÙØ© ÙسØ٠اÙأدÙا٠ÙÙا ÙØÙÙÙ٠أز٠ات اÙدÙÙ Ùعد٠ضبطÙا ÙÙتطÙر ÙاÙÙÙا٠بإصÙاØات جذرÙØ© ÙصاÙØ Ø§Ùج٠اÙÙر اÙعربÙØ© Ù ÙساÙÙ٠٠ع اÙتدÙÙر اÙعا٠ÙÙ Ùع٠Ùذ٠اÙج٠اÙÙر Ù ÙرسÙ٠اÙتخÙÙ ÙÙÙا.
Ù٠اÙز٠٠اÙراÙÙ ÙØ°ÙÙ Ùتصاعد اÙØ´ÙÙ٠اÙÙاعÙÙاÙ٠٠٠اÙÙع٠ÙاÙتطÙØ±Ø ÙÙا تعر٠اÙج٠اÙÙر ÙÙ٠تغÙØ±Ø ÙتتدÙ٠ج٠اÙÙر٠٠تخÙÙØ© Ù٠اÙدرس ÙاÙع٠٠عÙ٠اÙ٠د٠ÙØªØ·Ø±Ø Ù Ø³ØªÙÙات ÙÙÙ Ùا اÙ٠تخÙÙØ©.
ÙتÙÙد Ùذ٠اÙ٠عارضات ÙØ·Ø±Ø Ø§Ùبرا٠ج اÙÙ ØاÙظة Ø¥Ù٠اÙÙسا٠اÙÙاس ÙتأÙÙد اÙÙÙض٠Ùعد٠اÙتÙØØ¯Ø ÙتتÙج٠Ùئات اÙبرجÙازÙØ© اÙصغÙرة ÙتأÙÙد اÙصاعد اÙØ°Ù Ùزداد طائÙÙØ© ÙتخÙÙا٠ÙتÙÙÙÙا٠ÙÙصÙÙÙ ÙاÙعÙدة ÙÙÙراء.
ÙÙذا تÙÙس٠اÙÙÙابات ÙاÙ٠عارضة ÙاÙأشÙا٠اÙتÙØÙدÙØ© Ù٠اÙع٠٠اÙسÙاس٠ÙتتÙج٠Ùئات٠اÙبرجÙازÙØ© اÙصغÙرة ÙتأÙÙد اÙÙاعÙÙ Ù٠اÙ٠عارضة أ٠اÙÙ ÙاÙØ§Ø©Ø ÙÙغد٠اÙØ¥Ùطاع اÙدÙÙÙ Ù٠اÙØ£ÙÙÙ ÙÙÙذا Ùر٠اÙاÙسا٠بÙ٠اÙدÙ٠اÙإسÙا٠ÙØ© ب٠ÙØÙÙÙØ Ø·Ø§Ø¦ÙÙÙ٠رئÙسÙÙ٠خطرÙ٠٠تصاد٠ÙÙ.
ÙÙغد٠اÙخرÙج ٠٠اÙعصر اÙØدÙØ« Ùت٠زÙ٠اÙبÙدا٠ÙÙشر اÙÙÙض٠ÙاÙتخÙÙ ÙاÙØرÙب Ù٠اÙبرÙا٠ج اÙØÙÙÙÙ ÙÙؤÙاء اÙØ°ÙÙ ÙرÙبÙ٠اÙÙ Ùجات ÙÙا ÙÙد٠ÙÙ ØÙرا٠ع٠ÙÙا٠Ù٠اÙØÙاة ÙÙا ÙضØÙ٠ب٠ÙرÙدÙ٠اÙÙاس Ù٠اÙØ°ÙÙ ÙضØÙ٠٠٠أجÙÙÙ . ÙÙ Ù ÙÙا ÙجدÙÙ ÙÙÙÙ Ù٠عÙاÙات ٠شبÙÙØ© ٠ع Ù٠اÙجÙات Øسب اÙÙÙائد اÙت٠ÙجÙÙÙÙا.
اÙتÙازÙØ©Ù ÙÙ ÙذجÙØ©Ù
Ù ÙØ° أ٠أخطأ بعض٠٠٠أÙراد اÙجÙ٠اÙÙØ·Ù٠اÙÙدÙÙ Ù٠اÙتØاÙ٠٠ع اÙطائÙÙÙÙØ Ùظرا٠ÙÙشاشة جذÙرÙ٠اÙÙÙرÙØ© اÙسÙاسÙØ© اÙعÙ٠اÙÙØ© اÙÙØ·ÙÙØ©Ø ÙاÙأعشاب اÙضارة تتاÙÙ Ù Ù Ùذا اÙÙ Ùبت.
Ùا٠اÙجÙ٠بتضØÙات٠Ù٠غا٠رات٠ÙÙا٠٠٠اÙضرÙر٠ÙÙدÙØ ÙÙ٠اÙØاÙØ© اÙÙÙ ÙذجÙØ© اÙاÙتÙازÙØ© رغ٠تÙرارÙا ÙØ£ÙÙ ÙØ© اÙعÙÙاÙÙØ© ÙاÙÙدÙØ¡ اÙتØÙÙÙÙ Ùبعد اÙÙظر ترÙØ ØªØµØ±Ø® Ùائجة ÙتØÙ٠اÙÙ ÙÙÙ ÙتشرÙØ Ø§ÙجÙ٠اÙÙدÙÙ ÙØاÙة٠تشÙج٠شخصÙØ© بدÙا٠٠٠تطبÙ٠تÙ٠اÙÙ Ùردات اÙÙبÙرة Ù٠اÙÙ ÙضÙعÙØ© ÙاÙعÙÙ ÙØ© ÙÙÙ٠اÙÙائ٠اÙÙاÙد Ùا ÙعجبÙا ÙÙا ÙÙترب ٠٠٠ستÙÙعÙا ÙاÙتÙازÙÙا.
ÙÙÙ Ù٠أ٠ÙستÙÙد بعض اÙ٠تعÙÙ ÙÙ Ù Ù Ø®ÙÙÙاتÙ٠اÙسابÙØ©Ø ÙÙتÙاعبÙا Ø£Ùثر بÙضاÙا اÙÙضا٠بدÙا٠٠٠تجاÙز اÙجÙ٠اÙÙدÙ٠اÙØ°Ù ÙÙ ØªØªØ ÙÙ Ùرص اÙدراسة اÙØ£ÙادÙÙ ÙØ©.
Ø®ÙØ·Ù٠بÙ٠اÙع٠٠اÙسÙاس٠ÙاÙدÙÙ Ùغد٠تÙاعباÙØ ÙÙ٠٠٠اÙ٠تعبدÙÙ Ù٠٠اÙاÙتÙازÙÙÙ. Ùأ٠جÙØ© تجÙب ٠صÙØØ© ذاتÙØ© ÙÙ Ù٠تسÙÙÙÙا. Ù Ù ØÙ٠أ٠تصÙÙ ÙÙÙ ÙÙس Ù Ù ØÙ٠أ٠تÙغ٠تارÙØ® اÙتÙار اÙÙØ·ÙÙ Ù٠اÙعÙ٠اÙÙØ© ÙÙص٠اÙدÙ٠ع٠اÙسÙاسة!
ØÙÙ Ùغد٠اÙصراع اÙسÙاس٠اÙطائÙÙ ØاÙØ© اشتبا٠عا٠ة Ùجر٠تصÙÙرة ÙØ«Ùرة Ùجر اÙÙØ·ÙÙÙ٠إÙÙÙØ ÙØÙÙ ÙÙØ´Ù Ùتبد٠اÙÙÙØ§Ø¹Ø ÙتÙÙÙض٠اÙ٠صÙØØ© اÙخاصة. ÙÙا تÙÙÙÙد Ùذ٠اÙأخطاء ÙتÙÙØÙ٠ب٠تÙÙتر٠ÙÙاستÙادة ٠٠غ٠ÙضÙا!
Øت٠ÙÙارث اÙشعب اÙعار٠ة Ùا تÙج٠٠٠اÙÙÙتر اÙ٠صÙØ٠اÙØ°Ù ÙÙض٠بعض Ø®ÙراتÙا رغ٠اÙضØاÙا ÙاÙÙÙارث!
Ùتابات٠ÙزÙÙØ© تستÙÙد ٠٠أ٠٠ÙÙØ¹Ø ÙÙÙÙ Ùا اÙتراÙ٠اÙ٠اÙÙ Ùا اÙÙÙدÙØ Ùا تÙÙ٠بتجذÙر أ٠تØÙÙÙØ ÙتØاÙ٠اÙتÙÙÙ٠٠٠شأ٠اÙÙتابات اÙÙØ·ÙÙØ© اÙتÙد٠ÙØ© ÙتخرÙب Øت٠أس٠اء أصØابÙا ÙاÙتصغÙر Ù Ù ÙتاجاتÙÙ ÙاÙتعتÙ٠عÙÙ ÙجÙدÙ٠بأشÙا٠صبÙاÙÙØ©.
Ùذا اÙØÙد Ùتاج تضخ٠ذات٠Ùإعطاء Ùذ٠اÙذات اÙÙزÙÙØ© ÙÙرÙا٠٠Ùا٠ا٠رÙÙعاÙØ ÙÙÙ Ùجب أ٠تÙÙ٠اÙÙائد اÙØ£ÙÙ ÙاÙزعÙ٠اÙ٠عتر٠ب٠رغ٠اÙÙزا٠اÙÙÙر٠ÙاÙتÙاعب اÙسÙاس٠ÙغÙاب اÙÙتاج اÙÙ ÙضÙع٠اÙدارس ÙÙبÙ٠اÙاجت٠اعÙØ© ÙاÙصراعات اÙطبÙÙØ©.
تخرÙب اÙتÙار Ù٠جزء ٠٠اÙ٠صÙØØ© اÙذاتÙØ© ÙÙÙ٠ا Ùثر اÙع٠Ùا٠اÙ٠تخبطÙÙ Ù٠اÙÙÙ٠اÙسÙاس٠ÙÙ٠ا Ùجدت Ùذ٠اÙذات Ùرصا٠ÙÙتÙاعب ب٠صÙر اÙÙØ·Ù ÙاÙÙاس.
Ù٠جزء Ù Ù Ùذا اÙخراب اÙذ٠أ٠تد عÙÙدا٠ÙÙ٠خرÙ٠اÙÙسار ØÙØ« Ùا جد٠ع٠ÙÙ ÙÙا شخصÙات تؤص٠اÙ٠اض٠Ùتصعد بإÙجازاتÙØ ÙÙ٠٠شغÙÙØ© ب٠ÙاÙعÙا ÙاستغÙاÙÙا ÙÙ٠اض٠ÙاÙØØ§Ø¶Ø±Ø Ø£Ù Ù٠جا٠دة Ùا تÙرأ Ùتدرس.
ÙÙاÙÙ٠اÙاÙتÙازÙØ©
ÙÙاÙتÙازÙØ© سÙاء ÙاÙت ÙسارÙØ© Ø£Ù ÙÙ ÙÙÙØ©Ø Ø¹Ù٠اÙÙØ© أ٠دÙÙÙØ©Ø Ù٠اÙسÙطة Ø£Ù Ù٠اÙÙ Ø¹Ø§Ø±Ø¶Ø©Ø ÙÙاÙÙ٠٠شترÙØ©.
ÙÙد ع٠٠اÙاÙتÙازÙÙÙ Ù٠صÙÙ٠اÙÙسار Ø·ÙÙÙا٠Ùعد٠تÙØدÙØ ÙÙتضارب شخÙص٠Ùر٠Ùز٠ÙÙÙاعدÙØ ÙÙعد٠إÙتاج ÙÙر ٠ستÙÙ ÙÙØ Ø¨Ùد٠عد٠ÙجÙد ÙÙاÙÙÙ Ù ÙضÙعÙØ© ÙÙÙر٠ÙÙÙÙاÙ٠عÙ٠اÙأرض تØاسبÙÙ Ø ÙباÙتاÙÙ ÙÙ ÙÙÙ٠اÙتØر٠ÙاستغÙا٠تÙ٠اÙÙÙاعد اÙÙ ÙÙÙÙØ©Ø Ù٠صاÙØÙ٠اÙشخصÙØ©.
ÙÙÙذا Ù٠اÙÙÙÙ ÙتعÙزÙ٠عÙ٠اÙدÙÙÙÙ٠أ٠عÙ٠ج٠اعات صغÙرة شخصÙØ© ÙعدÙÙ Ø© اÙÙعÙØ Ù Ù Ø£Ø¬Ù ÙصÙÙÙÙ ÙÙراس٠اÙسÙطة بشت٠أÙÙاعÙØ§Ø ÙÙÙثرÙØ©. ÙØ°Ù٠اÙÙخر داخ٠اÙØرÙØ© اÙÙسارÙØ© ÙإطÙاء جذÙØ© ÙعÙÙا ÙعدساتÙا اÙضÙئÙØ© اÙاجت٠اعÙØ©Ø Ù Ù Ø£Ø¬Ù ØرÙتÙ٠اÙÙردÙØ©Ø ÙسطÙتÙÙ Ø ÙعÙا٠ات ÙؤÙاء اÙÙارÙØ© Ù٠اÙغرÙر ÙاÙتضخ٠اÙشخص٠Ùبث اÙعداÙØ© بÙ٠اÙÙسار Ùربط٠باÙÙÙ٠اÙÙ ØاÙظة اÙسÙاسÙØ© ÙاÙدÙÙÙØ© ÙÙط٠ث٠ار اÙثرÙØ©.
ÙÙذا ٠ا ÙÙÙ٠ب٠اÙجÙ٠اÙجدÙد ٠٠اÙاÙتÙازÙØ© داخ٠اÙØرÙات اÙدÙÙÙØ©Ø ÙÙÙ Ùصعد عÙ٠تضØÙاتÙØ§Ø ÙÙÙاعدÙØ§Ø ÙÙا ÙÙÙ٠بÙØ´Ù ÙÙاÙÙ٠اÙØ«ÙاÙØ© اÙإسÙا٠ÙØ©Ø Ø¹Ø¨Ø± درس تجربتÙØ§Ø Ùأسباب اÙÙÙار ØضاراتÙØ§Ø ÙتÙاÙضات ØرÙاتÙØ§Ø ÙÙÙÙÙØ© تÙØدÙا باÙج٠اÙÙر اÙعا٠ÙØ©Ø Ù Ù Ø£Ø¬Ù Ø£Ù ØªØ¸Ù Ø§ÙÙÙاعد ع٠ÙØ§Ø¡Ø ÙاÙتÙظÙ٠ات بÙا ÙÙاÙÙ٠دÙÙ ÙراطÙØ©Ø ÙÙا Ùت٠اÙتÙرÙ٠بÙ٠اÙ٠ضØÙÙ ÙاÙØ´Ùداء ÙبÙ٠اÙÙصÙص.
إ٠اÙتÙازÙ٠اÙÙسار ÙرÙدÙ٠أ٠ÙصعدÙا Ø¥Ù٠اÙبرÙ٠ا٠ÙاÙسÙطة دÙ٠تÙارات ÙÙÙØ© عÙ٠اÙØ£Ø±Ø¶Ø ÙضØÙ٠٠٠أج٠زرعÙا ÙتÙÙÙ٠عÙÙÙتÙا اÙدÙÙ ÙراطÙØ© ب٠ÙعبÙا دÙرا٠ÙبÙرا٠Ù٠ت٠زÙÙÙØ§Ø ÙÙتعÙزÙ٠عÙ٠تضØÙات غÙرÙÙ Ø Ø§ÙØ°Ù Ùا ÙÙصÙÙ٠إÙا بشرÙØ· Ù٠أ٠ÙÙÙرÙا ÙعÙÙ٠اÙÙسارÙØ ÙÙصÙرÙا Ø£Ùرادا٠Ùا ÙعبرÙ٠ع٠ÙÙر.
ÙبÙ٠اÙتÙازÙ٠اÙÙÙ Ù٠اÙدÙÙÙ ÙØ£ÙÙئ٠عÙا٠ات ٠شترÙØ©Ø Ù٠أ٠اÙاÙتÙازÙÙÙ Ù٠اÙØرÙات اÙدÙÙÙØ© ÙÙد استÙدÙا عÙÙ ÙÙاعد Ù ÙتÙخة Ù٠اÙØ Ø¹Ø§Ø·ÙØ© ٠٠اÙÙع٠ÙÙÙاÙØ ÙØبذÙÙ Ùذا اÙÙÙع ٠٠اÙاÙتÙازÙØ© اÙÙسارÙØ©Ø ÙاÙد٠ÙاØØ¯Ø ÙÙÙ ÙÙÙÙÙÙ ÙÙÙاعدÙÙ ÙرÙد Ù Ø«Ù ÙؤÙاء اÙØ°ÙÙ ÙعطÙÙÙ ÙÙاÙÙ٠اÙÙع٠ÙاÙدÙÙ ÙراطÙØ©Ø ÙÙÙ ÙعÙدÙ٠إÙتاج Ùذا اÙÙÙ Ø· داخ٠ØرÙاتÙÙ Ø ÙØ£ÙÙ٠غÙر ÙادرÙ٠عÙ٠إÙتاج Ø«ÙاÙØ© إسÙا٠ÙØ© دÙÙ ÙراطÙØ©Ø ØªÙترض اÙÙØدة ÙاÙعÙدة ÙجذÙر اÙÙضا٠اÙÙ ÙضÙعÙØ© ÙاÙاستÙاد عÙÙ ØرÙØ© اÙج٠ÙÙر اÙÙ Ùظ٠اÙ٠سئÙ٠اÙسائÙ.
ÙÙ٠ا عاÙت ØرÙØ© اÙÙسار ٠٠اÙاÙتÙازÙØ© Ù٠صÙÙÙÙا ÙسÙ٠تعاÙ٠اÙØرÙات اÙدÙÙÙØ© ٠٠اÙاÙتÙازÙØ© Ù٠صÙÙÙÙا سÙاء٠بسÙØ§Ø¡Ø ÙÙؤÙاء ÙضعÙÙ ÙظاراتÙ٠اÙÙ Ùبرة عÙ٠اÙÙراس٠ÙاÙثرÙØ©Ø ÙÙÙ ÙÙÙ ÙدÙÙ٠إÙتاج ÙÙر٠ÙØدد خطÙاتÙ٠عÙ٠اÙØ£Ø±Ø¶Ø ÙباÙتاÙ٠تغد٠ØرÙاتÙ٠دائ٠ا٠ذاتÙØ© ÙÙÙÙØ© اعتباطÙØ©Ø Ø¨Ùا دستÙر ÙؤطرÙØ§Ø ÙÙا ÙاÙÙÙ ÙضبطÙØ§Ø ÙÙا ÙÙاعد تØاسب عÙÙÙا.
ÙÙÙذا تعت٠د اÙØرÙات اÙ٠صÙÙØ© بÙذا اÙØ´Ù٠عÙ٠عد٠خÙ٠اÙÙتاج اÙÙÙر٠اÙ٠ؤطر اÙÙ ÙÙÙتج بشÙÙ Ø·ÙÙع٠ÙاÙÙ ÙÙاÙØ´ بشÙ٠ج٠اÙÙر٠ب٠تعت٠د عÙÙ ÙÙتات اÙزعÙ٠دا٠ظÙÙ.
ÙÙÙ ÙÙÙ Ù Ù٠أÙص٠اÙÙسار ÙÙÙ ÙÙ٠٠آخر Ù٠أÙص٠اÙÙÙ ÙÙØ ÙÙ٠اذا جر٠Ùذا اÙاÙتÙا٠اÙعÙÙÙØ ÙØ£ÙÙ Ø°Ùبت اÙتضØÙات ÙÙÙ٠ضاعت ساعات اÙع٠٠ÙاÙجÙÙد ÙاÙز٠ا٠ÙÙذا ÙÙÙ Ùا ÙÙÙ ÙاÙÙ Ù٠أ٠اÙزعÙ٠جاءت٠عÙØ§Ù Ø©Ø ÙØضرت Ù٠خاطرة بارÙØ© عظÙÙ Ø©Ø ÙØÙ٠٠سار اÙÙØ·Ùع.
ÙÙذا اÙأ٠ر ÙÙس٠Ù٠اÙدÙÙØ©Ø ÙاÙاÙتÙازÙØ© Ù ÙجÙدة ÙÙ ÙÙ Ù ÙاÙØ ÙاÙاÙتÙازÙÙ٠اÙØÙÙÙ ÙÙÙ Ùا ÙرÙدÙ٠أ٠تÙÙÙ ÙÙدÙÙØ© ÙÙØ§Ø¹Ø¯Ø ØªØدد تÙاس٠اÙثرÙØ© ÙÙÙÙÙØ© إجراء اÙÙ ÙاÙصات ÙÙÙ٠تÙÙØدد اÙÙ ÙزاÙÙØ© بشÙ٠عÙÙ Ù ÙÙÙ٠تÙÙÙاÙØ´ بشÙ٠شعبÙØ ÙÙا ÙرÙدÙ٠أ٠تÙÙعر٠دخÙ٠اÙشرÙات ÙØ£Ù٠تذÙØ¨Ø ÙØ£Ù Ùظ٠ÙÙا٠اÙØ®ÙØ· اÙسر٠ÙتÙزÙع اÙثرÙØ© ÙÙØ¨Ø¹Ø¶Ø ÙÙÙ Ù Ø«ÙÙ٠٠ث٠بÙÙØ© اÙاÙتÙازÙÙÙ ÙÙÙدÙ٠اÙ٠جت٠ع ÙÙÙÙا٠Ù٠سبÙ٠صاÙØÙÙ .
تتÙÙ Ùذ٠اÙÙÙÙ ÙÙÙا عÙ٠إبÙاء Ùعبة اÙسÙاسة Ù٠أÙدÙÙØ§Ø ÙÙÙÙÙØ© تÙزÙع اÙأدÙار بÙÙÙØ§Ø ÙتغذÙØ© بعضÙا بعضاÙØ ÙÙ٠اÙÙÙاÙØ© ÙبÙ٠اÙع٠ا٠ع٠اÙا٠ÙÙ ØدÙد٠دخ٠بÙÙ٠ا Ùصعد اÙاÙتÙازÙÙÙ ÙÙØصÙÙ٠عÙ٠اÙÙÙÙ ÙاÙبÙÙت ÙاÙأرصدة ÙÙØ°ÙبÙÙ ÙÙ٠ؤت٠رات ÙÙصدرÙ٠اÙÙتب ع٠إÙجازاتÙÙ ÙÙضاÙÙ٠اÙÙبÙر ٠٠أج٠اÙج٠اÙÙر!
اÙاÙتÙازÙØ© ÙاÙÙ ÙضÙعÙØ©
٠٠اÙصعب Ø£Ù ÙÙÙ٠اÙاÙتÙاز٠٠ÙضÙعÙاÙØ ÙÙÙ Ùر٠اÙجÙØ© اÙت٠ÙستÙÙد Ù ÙÙا Ùأعظ٠اÙجÙØ§ØªØ ÙاÙجÙØ© اÙت٠Ùخسر Ù ÙÙا ÙأسÙاء اÙجÙØ§ØªØ ÙÙÙذا Ùا Ùر٠أ٠جاÙب Ø¥Ùجاب٠Ù٠اÙجÙØ© اÙت٠تعارض ٠صÙØتÙØ ÙÙا Ùر٠أ٠اÙجÙØ© اÙت٠ÙستÙÙد Ù ÙÙا تسبب اÙأضرار ÙÙآخرÙÙ.
ÙØÙÙ ØªØµØ¨Ø Ø§Ù٠صÙØØ© اÙذاتÙØ© Ù ÙسÙرة٠ÙÙجÙات اÙÙظر اÙÙÙرÙØ© ÙاÙسÙاسÙØ©Ø Ùتشاب٠اÙذات٠ÙاÙÙ ÙضÙعÙØ ÙتضÙع اÙØÙÙÙØ© !
ÙÙÙذا ØÙ٠تصط٠ج٠عÙات عدÙدة ٠ع اÙدÙÙØ© ÙØ£ÙÙا تستÙÙد Ù ÙÙØ§Ø ÙتختÙÙ Ùغة اÙÙÙد اÙÙ ÙضÙع٠٠ÙÙØ§Ø ØÙØ« إذا رأت Ø´Ùئا٠سÙبÙا٠٠٠اÙدÙÙØ© ØµÙ ØªØªØ Ùإذا رأت Ø´Ùئا٠إÙجابÙا٠اÙدÙعت تÙÙج باÙÙ Ùاسب ÙاÙ٠آثر.
ÙعÙ٠اÙعÙس ØÙ٠تر٠شÙئا٠إÙجابÙا٠Ù٠اÙخصÙ٠تسÙØªØ ÙÙا تشÙر Ø¥ÙÙ Ùذا اÙØ¥Ùجاب٠ÙÙØ£ÙÙ ÙÙ ÙÙÙØ ÙØÙ٠تر٠شÙئا٠سÙبÙا٠تÙدÙع Ùإصدار اÙبÙاÙات ÙاÙتصرÙØات.
بطبÙعة اÙØا٠ÙÙ Ùستخد٠ÙÙ ÙÙا Ùغة تتظاÙر باÙÙ ÙضÙعÙØ©Ø ÙاÙصد٠ÙاÙÙØ·ÙÙØ©Ø ÙاÙØÙاظ عÙ٠٠صاÙØ Ø§Ùشعب اÙعÙÙا ÙضرÙرة رؤÙØ© اÙتÙد٠ÙاÙØªØ³Ø§Ù Ø Ø§ÙØ®..!
ÙتÙع٠اÙج٠عÙات اÙأخر٠ذات اÙأ٠ر Ø Ùتتبع ÙÙس اÙØ®Ø·Ø ÙÙÙÙ Ù٠صÙØØ© ٠ختÙÙØ©. Ùإذا Ùا٠ت اÙدÙÙØ© بشÙØ¡ Ø¥Ùجاب٠سÙØªØªØ Ø£Ù ØªØدثت ع٠اÙÙÙاÙص اÙÙبÙرة ÙÙ Ùذا اÙØ¥ÙØ¬Ø§Ø²Ø ÙØªØµØ¨Ø Ø£ØÙاÙا٠اÙتØÙÙات اÙÙ ÙÙ Ø© Ù٠اÙØÙاة اÙسÙاسÙØ© بعد عÙÙد اÙجÙا٠ÙÙØ£ÙÙا تخÙ٠٠٠أ٠شÙØ¡ Ø¥Ùجاب٠Ù٠اÙ٠سائ٠اÙÙ ÙصÙÙØ© ÙÙØÙاة اÙسÙاسÙØ©.
ÙØÙÙ ÙÙÙ٠أصدÙاؤÙا بأع٠ا٠٠ا ترÙعÙا Ø¥Ù٠اÙØ³Ù Ø§Ø¡Ø ÙÙا تشÙر Ø¥Ù٠أ٠جاÙب سÙبÙØ Ùخطر عÙ٠اÙØÙاة اÙسÙاسÙØ© ÙاÙاجت٠اعÙØ©Ø ÙÙØ£ÙÙا تÙد٠ÙؤÙاء ÙØ£ÙÙÙ ØÙ Ùا٠أ٠غزÙاÙØ ÙÙا تر٠ع٠ÙÙات اÙتØØ´Ùد اÙسÙبÙØ© أ٠تراÙ٠اÙجÙÙ Ù٠اÙج٠ÙÙر Ùعد٠تبصÙر٠باÙØÙائ٠ع٠Ùذ٠اÙظÙاÙØ±Ø ÙÙØ· ÙØ£ÙÙا ظÙاÙر صدÙÙØ©Ø ÙصدÙÙÙ Ù ÙÙÙØ® ÙاÙباÙÙÙ ÙعدÙ٠٠خسÙ٠إÙ٠أسÙ٠ساÙÙÙÙ !
إ٠اÙرؤÙØ© اÙذاتÙØ© ÙÙØ§Ø Ø³Ùاء عÙد Ù Ùاصر٠اÙدÙÙØ© اÙأشداء أ٠خصÙÙ Ùا اÙØ£Ø´Ø¯Ø§Ø¡Ø Ùا تÙتج ØاÙØ© سÙاسÙØ© ÙØ«ÙاÙÙØ© صØÙØ©Ø ÙÙا تÙÙÙ ÙعÙا٠٠ÙضÙعÙا٠ÙتراÙ٠عÙد اÙÙØ§Ø³Ø Ø¨Ù ØªÙÙ٠عÙÙ Ø«ÙاÙØ© اÙØ´Ø٠اÙاÙتÙازÙØ© اÙت٠Ùا تتبصر اÙطر٠ÙÙ ÙعرجاتÙا اÙÙØ§Ø¯Ù Ø©Ø ÙÙÙÙدÙا سائ٠٠سرع٠Ùا ÙÙÙر سÙ٠باÙÙصÙ٠إÙÙ Ùجبت٠اÙساخÙØ©Ø ÙÙا ÙÙت٠باÙ٠ارة Ùإشارات اÙ٠رÙر !
ÙÙÙÙ ÙظÙر Ù Ù Ùذ٠اÙØاÙات اÙذاتÙØ© اÙ٠صÙØÙØ© Ø£Ùاس٠ÙتبصرÙ٠ب٠ÙضÙعÙØ© اÙأشÙØ§Ø¡Ø ÙÙغدÙ٠أÙثر ØÙÙ Ø© ÙعÙÙاÙØ ÙÙÙÙÙ Ù٠بتغÙÙر زÙاÙا رؤÙتÙÙ ÙÙÙتشÙÙÙ Ù٠خصÙÙ ÙÙ ÙÙاطا٠إÙجابÙØ©Ø ÙÙ٠أصدÙائÙÙ ÙÙاطا٠سÙبÙØ©.
ÙعÙ٠٠د٠Ùشاط ÙؤÙاء اÙÙ ÙضÙعÙÙÙ Ùتج٠ÙعÙÙ ÙÙÙÙ٠اÙسÙاسÙØ©Ø ÙترÙÙزÙ٠عÙ٠اÙسÙب٠أÙا٠Ùا٠٠صدرÙØ ÙاÙØ¥Ùجاب٠أÙا٠Ùا٠٠ÙÙØ°ÙØ ØªØªÙÙ٠اÙع٠ÙÙات اÙسÙاسÙØ© ÙاÙÙÙرÙØ© ÙاÙتغÙÙرات ÙاتجاÙÙا.
ÙÙÙ٠ا أزداد عدد ÙؤÙاء Ù٠٠ختÙ٠اÙج٠عÙات ÙاÙتÙارات ÙÙاضÙÙا بجرأة ٠٠أج٠اÙÙ ÙضÙعÙØ© اÙÙÙرÙØ© ÙاÙأ٠اÙØ© اÙسÙاسÙØ©Ø ÙÙ٠ا ترسخت خطÙØ· اÙعÙÙاÙÙØ© ÙاÙدÙاع ع٠اÙ٠صÙØØ© اÙØ¹Ø§Ù Ø©Ø ÙÙزداد اÙØصار Ø£ÙÙئ٠اÙØ°ÙÙ ÙÙرسÙ٠٠صاÙØÙ٠اÙØ®Ø§ØµØ©Ø Ø¨Ø§Ø¹ØªØ¨Ø§Ø±Ùا Ù٠اÙÙØ·Ù ÙاÙØÙÙÙØ© ÙاÙ٠ستÙبÙ.
ÙÙÙ ÙؤÙاء اÙذاتÙÙ٠اÙ٠صÙØÙÙÙ ÙÙسÙا ضعاÙاÙØ Ø¨Ù Ù٠أÙÙÙØ§Ø¡Ø ÙÙست٠دÙÙ ÙÙتÙ٠أساسا٠٠٠تÙÙ٠اÙÙ ÙضÙعÙÙÙ ÙأصØاب اÙÙزاÙØ©Ø ÙÙ Ù ÙÙØ© اÙ٠داÙعÙ٠ع٠اÙ٠صÙØØ© اÙعا٠ة بشÙ٠٠ستÙÙÙ ÙÙÙÙØ ÙÙ٠اÙÙضا٠اÙسÙاس٠Ùعت٠د عÙ٠اÙتغÙب عÙÙ ÙؤÙاء بأدÙات اÙÙضÙØ ÙاÙÙØ´Ù ÙاÙتعاÙ٠بÙ٠٠ختÙ٠اÙعÙاصر اÙÙزÙÙØ©.
إ٠اÙاÙتÙازÙØ© تتÙش٠عبر اÙتØÙÙ٠اÙÙاسع ÙاÙÙ ÙضÙع٠Ùعبر اÙÙضا٠اÙ٠شتر٠ÙتعرÙØ© اÙØ£ÙÙعة اÙ٠ختÙÙØ©.
أسباب اÙاÙتÙازÙØ© Ù٠اÙÙسار
تعÙد أسباب اÙتشار اÙاÙتÙازÙØ© Ù٠اÙÙسار Ø¥Ù٠عجز٠اÙÙÙر٠ع٠اÙتØÙÙÙØ ÙÙ٠اÙØÙاة اÙسÙاسÙØ© ت٠ث٠تÙ٠اÙتÙازÙØ© Ù Ù Ùب٠اÙÙÙ٠اÙÙÙادÙØ© ÙÙÙØ Ù٠شارÙØ© ÙÙ٠اÙاستغÙا٠ÙÙ Ø´ÙØ¡ ٠٠غÙائ٠اÙ٠ا٠اÙعا٠.
ÙÙÙذا Ùت٠غض اÙÙظر ع٠جÙاÙب ÙاÙترÙÙز عÙ٠جÙاÙØ¨Ø Ø¨Ùد٠إظÙار Øس٠اÙÙÙاÙا سÙاء ÙÙØ¥Ùطاع اÙÙ Ø°Ùب٠أ٠اÙسÙاسÙØ Ø¨ØÙØ« تبد٠ÙجÙØ© اÙÙظر اÙ٠ساÙØ© ٠تÙÙØ© ٠ع Ùضا٠اÙشعب ÙاÙدÙÙ ÙراطÙØ© ÙاÙÙØ·ÙÙØ© اÙØ®Ø ÙÙÙ Ù Ù ÙØ·ÙÙÙا ÙØسب Øسابا٠طبÙÙا٠استث٠ارÙا٠ÙÙÙ ÙÙد٠Ùخد٠ة ٠صÙØتÙ.
ØÙÙ ÙÙاج٠اÙدÙÙÙÙ٠بÙسÙØ© ÙÙÙ ÙÙصد ÙÙا إظÙار ÙÙس٠تØدÙØ«Ùا٠رس٠Ùا٠ÙØ¥ÙÙ ÙصÙØ ÙÙارتÙاع Ø¥ÙÙ Ù Ùا٠اÙÙ ÙظÙÙ٠اÙÙØ¨Ø§Ø±Ø ÙØÙÙ ÙÙاج٠اÙرس٠ÙÙ٠بÙسÙØ© ٠٠اثÙØ© ÙرÙد ٠غازÙØ© اÙدÙÙÙÙÙ ÙÙÙ ÙصعدÙ٠إÙ٠٠راتبÙ٠اÙعÙÙØ©.
ÙتتشÙÙ ÙÙا Ø£Ùسا٠جزئÙØ© أخر٠داخÙÙØ© ض٠٠Ùذا اÙتعدد اÙسÙاس٠ÙاÙطائÙ٠اÙ٠تÙÙØ¹Ø ÙÙذا Ùغاز٠طائÙØ© Ùآخر Ùغاز٠طائÙØ© ÙثاÙØ« Ùغاز٠جÙاØا٠Ù٠اÙسÙطة Ùآخر Ùغاز٠جÙاØØ§Ù Ø¢Ø®Ø±Ø Ùخا٠س Ùغاز٠جÙاØا٠Ù٠اÙج٠اعة اÙÙ Ø°ÙبÙØ© اÙÙ ÙØ´ÙØ© ÙÙÙذا دÙاÙÙÙ ÙÙÙÙ ÙؤÙاء بجرÙا Ø¥Ù٠اÙخراب اÙطائÙÙ..
ÙبدÙا٠٠٠Ùشر اÙÙع٠اÙدÙÙ Ùراط٠بÙ٠اÙÙاس ÙÙع٠أساس٠Ùجر٠Ùشر اÙÙع٠اÙØ´Ù ÙÙÙ ÙتغÙÙب اÙعÙاصر اÙاÙتÙازÙØ©..
إ٠اÙØ°Ù٠أÙدÙا Ø¥Ùجازات اÙتØÙÙات ÙسÙا سÙبÙاتÙا ÙØ£ÙÙÙ ÙبضÙا ث٠٠اÙسÙÙت ع٠اÙسÙب٠ÙرÙزÙا عÙ٠اÙØ¥ÙجابÙ..!
ÙاÙØ°Ù٠رÙزÙا عÙ٠اÙسÙب٠سرعا٠٠ا ÙÙزÙا Ùاستث٠ار Ø¥ÙجابÙاتÙا دÙÙ Ø°Ùر Ùذ٠اÙØ¥ÙجابÙØ§ØªØ Ùأ٠اÙج٠ÙÙر اÙذ٠صÙعÙا ÙعÙ٠عÙÙ ÙراÙÙØ© اÙÙظا٠Ùا ÙستسÙغ Ù Ø«Ù Ùذ٠اÙÙÙزة اÙبÙÙÙاÙÙØ©!
ÙÙ٠إذ ÙرÙد ٠عارضة اÙسÙاسة اÙسائدة ÙرÙد تØÙÙات Ù٠رÙاتب٠Ù٠ساÙÙÙ ÙØ£Øجا٠ع٠اÙتÙØ ÙÙ٠اÙØ°ÙÙ ÙتسÙÙÙ٠عÙÙ ÙضاÙÙ Ù٠شاعر٠ÙرÙدÙ٠اÙÙصÙÙ ÙØ£ÙداÙÙ٠اÙخاصة ٠ع بعض اÙبÙارات اÙÙÙدÙØ©.
Ùإذ استطاعت ÙÙ٠اÙÙÙ Ù٠أ٠تزÙ٠تØرÙاتÙا اÙاستغÙاÙÙØ© تØت غطاء ÙØ«Ù٠٠٠اÙبخÙر اÙدÙÙÙØ ÙÙÙ ÙÙ٠اÙÙسار تاÙت ÙÙضØت اÙÙسا٠اتÙا اÙÙائ٠ة عÙ٠اÙØ£Ùدا٠اÙذاتÙØ©Ø ÙشارÙت Ù٠اÙتÙسÙ٠اÙطائÙÙ Ùتع٠ÙÙ٠بÙÙ Ùئات اÙشعب اÙ٠ختÙÙØ©.
Ùصار اÙÙصÙÙ ÙÙÙراس٠بدÙÙا٠ع٠إÙتاج Ø«ÙاÙØ© سÙاسÙØ© دÙÙ ÙراطÙØ© تØدÙØ«ÙØ© تÙزع عÙÙ ÙاÙØ© اÙسÙاÙØ Ùأ٠اÙتÙÙبات Ù٠اÙسÙر٠اÙسÙاس٠ÙاÙت ÙبÙرة Ùا تتÙØ Ø®ÙÙ ÙعÙØ ÙÙظÙر Ù ÙÙÙ Øاد Ø«Ù ÙعÙب٠٠ÙÙÙ Ù ÙاÙØ¶Ø ÙÙا ترد٠اÙÙÙØ© بÙ٠اÙÙ ÙÙÙÙÙ Ù Ù Ø®Ùا٠٠ÙاÙ٠عÙÙاÙÙØ© صبÙرة ÙÙ Ù٠اÙÙ ÙاÙÙ.
ÙÙذا ÙÙÙ ÙÙتت جبÙØ© اÙ٠عارضة Ùج٠ÙÙرÙا اÙØ°Ù Ùبدأ باÙاÙØسار ÙاÙتشتت ÙاÙت٠ز٠Ùرب٠ا اÙتضارب ٠ستÙبÙاÙ!
ÙظÙر ÙÙا٠اتجاÙا٠أساسÙا٠Ù٠اÙÙسار اÙاتجا٠اÙØ£ÙÙ Ù٠اتجا٠اÙتÙازÙØ ÙÙتÙج٠Ùدع٠اÙÙÙ Ù٠اÙدÙÙÙØ Ù Ùاب٠رشÙØ© سÙاسÙØ©Ø ÙاÙÙÙ Ù٠اÙدÙÙ٠أثبت Ø®Ùاء تجربت٠اÙسÙاسÙØ© سÙاء Ùد٠اÙÙ ÙاطعÙ٠أ٠اÙ٠شارÙÙÙØ Ø¨Ù ÙخطÙرة تسÙد٠عÙ٠اÙÙÙائ٠ÙاÙÙراسÙØ Ù٠ا ÙÙÙد Ø¥ÙÙ٠٠٠أخطار.
ÙاÙاتجا٠اÙثاÙÙ Øائر ٠تصارع Ù ØªØ°Ø¨Ø°Ø¨Ø Ø¨ÙÙ Øدة Ù٠اÙÙجÙ٠عÙ٠اÙتÙارات اÙدÙÙÙØ© اÙÙÙ ÙÙÙØ©Ø ÙبÙ٠اÙخشÙع ÙÙجÙÙ Ùا اÙخطر عÙ٠اÙتÙد٠اÙÙØ·ÙÙ.
ÙاÙاتجاÙا٠ÙÙÙ Ùا٠بعضÙÙ Ø§Ø ÙÙ٠ا Ùتاج خطة Ø®ÙÙØ© ٠شترÙØ©Ø ØªÙ Ùد اÙدرÙب ÙÙ٠تطرÙÙ٠اÙدÙÙÙÙÙ ÙÙÙ ÙتÙاتÙÙا ÙÙخربÙا..
ضع٠اÙÙسار ÙاÙتشار اÙاÙتÙازÙØ©
ÙÙاتا٠اÙس٠تا٠ت٠ثÙا٠ÙجÙ٠اÙع٠ÙØ©Ø ÙÙÙØ© اÙÙÙ Ù٠اÙÙ Ø°Ùب٠تستÙد٠إÙ٠ضع٠اÙÙسار Ùضع٠اÙÙسار ÙÙÙد Ø¥ÙÙ ÙÙØ© اÙÙÙ Ù٠اÙطائÙ٠بÙصائÙ٠اÙ٠ختÙÙØ©.
ÙاÙÙئات٠اÙÙسط٠اÙ٠رتÙزة عÙÙ Ùذا اÙÙع٠اÙÙÙ ÙÙ٠اÙÙ Ùتشر تÙÙد باÙضرÙرة Ø¥Ù٠اÙتÙاÙÙ ÙÙ ÙضاÙا اÙع٠ا٠ÙاÙÙ ÙظÙÙ٠ع٠Ù٠اÙØ ÙاÙÙع٠اÙÙ Ø°Ùب٠اÙسÙاس٠غÙر Ù Ùتز٠بأ٠برÙا٠ج Ù٠صÙØØ© اÙشغÙÙØ©Ø ÙÙ٠عبر Ùذا اÙغ٠Ùض اÙاجت٠اع٠ÙصÙÙعد٠بعض اÙراد٠ÙØÙازة اÙÙ Ùاسب.
إ٠اÙÙع٠اÙÙ Ø°Ùب٠اÙسÙاس٠ÙÙع٠اÙتÙاز٠ع٠ÙÙ ÙØتاج Ø¥ÙÙ Ù Ø«Ù Ùذا اÙغ٠Ùض Ùعد٠اÙارتباط باÙÙÙ٠اÙشعبÙØ© ÙتغÙÙر Ø£ÙضاعÙا اÙاجت٠اعÙØ©Ø ÙÙبÙائÙا Ù٠خد٠تÙ.
ÙÙجر٠ÙÙا استغÙا٠اÙإسÙا٠ÙØ®ÙÙ Ù Ø«Ù Ùذا اÙدخا٠اÙاجت٠اع٠ÙتصعÙد اÙاÙتÙازÙÙÙ.
ÙباÙتأÙÙد Ùجر٠ذÙ٠عبر اÙطائÙÙØ© ÙÙÙس عبر اÙتÙØÙد اÙإسÙا٠Ù.
ÙÙØÙ Ùت٠Ù٠أ٠ÙسÙرÙا عÙ٠درب ع٠ر ب٠اÙخطاب ÙعÙ٠ب٠أب٠طاÙب ÙÙ Ù ÙاÙØØ© اÙاستغÙاÙØ ÙÙÙ٠عÙ٠٠٠تÙرأ ٠زا٠Ùر٠Ùا داÙدØ
ÙاÙطائÙÙØ© بØد ذاتÙا إعÙا٠ع٠تÙسع ت٠زÙ٠اÙشعب ÙتÙسÙع Ùذا اÙ
اليسار في البحرين والانتهازية
 عبـــــــدالله خلـــــــيفة
عبـــــــدالله خلـــــــيفةكاتب وروائي
𝓐𝖇𝖉𝖚𝖑𝖑𝖆 𝓚𝖍𝖆𝖑𝖎𝖋𝖆
𝖆𝖚𝖙𝖍𝖔𝖗 𝖔𝖋 𝖘𝖙𝖔𝖗𝖎𝖊𝖘 𝖆𝖓𝖉 𝖓𝖔𝖛𝖊𝖑𝖘
21.10.2014 | 1.3.1948
#المنبر_التقدمي
البورجوازيون الصغار الانتهازيون
هم أساسُ العيارة والجمبزة والانتهازية وتخريب التطور، المنافقون المعاصرون، لهم في كل حزب موقع، ولهم في كل ثورة نصيب، ولهم في كل ثورة مضادة نصيب، وهم مع الفقراء والأغنياء، وهم مع اليسار واليمين، وهم مع الدينيين ومع الملحدين، وهم مع الحكم وأعدائه، وهم مع الحقيقة والباطل، كيفما شئت والمهم أن تدفع!
المهم أن تغذيهم بالأموال، أو بالشهرة والمجاملة والنفخ، فالأموال والجوائز والعطايا والكراسي تغذي النشاط الفكري لديهم، تجعل مكوناتهم العقلية فجأة تتفتق بالاكتشافات المبهرة، والثلاجات المليئة باللحوم والسيارات والأراضي.
هم متخلفون في الفكر وإنتاج الكتب، نتاجهم مزيف، ليس فيه أي تحليل للصراعات الطبقية المعاصرة، لأنهم يرفضون أن يتخذوا موقفاً بين الفقراء والأغنياء، بين العمال والإقطاع والبرجوازية، عيارون جدد، ثم يتشدقون بالكثير مع الخرافات الحديثة والقديمة، وهم جبناء انتهازيون يهتمون كثيراً بجيوبهم، وليس بالدفاع عن الحقيقة والناس. من هنا لا يتعمقون في المعارك الاجتماعية والسياسية، فكيف يواصلون ذلك وفيها قطع أرزاقهم الوفيرة؟
فتجد دائماً أن كلماتهم تنصب في اتجاه معين وحيد، مستمر أبدي، لا يتحول ولا يتبدل، وكأنهم آلات ممغنطة وكائنات موجهة، تقرأهم وأنت في البيت دون الحاجة للقراءة، يخافون من أي توجه آخر، مدارون إلكترونياً من أقمار صناعية ومن مخافر كونية، كأنهم وُضعوا على سكك الحديد، لا يلتفتون يمنة أو يسرة، يدافعون عن حكومات، أو عن اتجاهات سائدة بالشعرة مهما ناوروا أو أدعوا، ولهم البنوك والمعاشات والكراسي والجوائز والمنافع والمناصب والبلاعات، فهي أفكار مدفوع لها سلفاً، وهي كتابات مأجورة مقدماً، وسخافات لانفع فيها وضررها كثير على العقول.
بين عشية وضحاها يتقلب البرجوازيون الصغار الانتهازيون، من العلمانية والثورة التقدمية إلى مساندة التخريف الديني، التخريف الديني والشعوذة وليس إلى تصحيح هذه المفاهيم وإنتاج عقلانية دينية مفيدة مهما كانت كذلك مصائبها، وينتقلون من الدعوة للثورة العمالية وانتفاضات الكادحين إلى خدمة الملالي والمجرمين المطاردين دولياًً، وتبرير الأرهاب بكل اشكاله لكن دون أن تصيب حصالاتهم وعائلاتهم المقدسة أي ضرر، ويعملون لخدمة الطائفيين وأجهزة الاستخبارات للدول القومية والدينية الدكتاتورية، (يا إلهي كيف يبيع هؤلاء الناسُ أنفسَهم بين عشية وضحاها ؟!).
والأدباء واللامبدعون لهم نصيبهم الكبير الوافر من هذه الانتهازية، وقد كنا ننتظر نضالهم وفضحهم للاستغلال وجلب العمالة الأجنبية الرثة والتصدي للدكتاتوريات وحكومات السرقة، في قصصهم وأشعارهم ورواياتهم، ولكن لا خبر جاءَ ولا نشرٌ نزل!
لكنهم يتعللون أن الأدب والفن ساميان لا يتلوثان بهذا الأسفاف الشعبي، وأنهما نائيان عن المادة، وعن الجمهور البسيط ومحدودية إدراكه وسذاجة مفاهيمه، ومع هذا فنجد أنهم مشغولون بالمادة الذهبية كثيراً، خاصة في شراء اللوحات وكسب الجوائز وطباعة الكتب مجاناً والحصول على تذاكر السفر وحضور المهرجانات بأبهة، ويقولون إن ليس لهم علاقة بالأجور والسفاف الدنيوية فهم من مادة صوفية أثيرية تضحوية خالدة إلا إذا انخفضت مرتباتهم الكبيرة، فسوف يجأرون بالشكوى كثيراً، لقد جفت أشعارهم ولوحاتهم وكتباتهم فقد نأوا عن نضال الشعب، وصارت الكلمة هي الحصالة، وصار الموقف تبعاً لأسعار البورصة، وقل أعطني شيئاً أكتب لك ما تشاء، ثم صار الهراءُ الشعري المادة السماوية التي منها يمتحون كل سخافاتهم وأعمالهم المسرحية والفنية وبراءتهم من دم يوسف! دم الشهداء والمناضلين! وتجدهم يهرجون في المسرح وفي الكتابة وفي السياسة ويظنون أن القراء والمشاهدين جهلة لا يعرفون ما وصلوا إليه من إنحدار ومن عجز عن المقاومة! هل إفادتهم كلماتهم ولوحاتهم وأصنامهم شيئاً إلا ما هو عابر؟
ولا يقل مواطنوهم وأقران السؤ الآخرون (الدينيون) عن هذا المثال (المشع)، بل لقد سبقوهم في العيارة والنصب على السذج، وهؤلاء تاجروا في الدين وهذه من أعظم الكبائر، وجعلوه مصيدة وحصالة فبئس ما يصنعون! إلا من ناضل جاهراً قوياً من أجل حقوق الناس لا تهمه في الحق لومة لائم وإذا صار لا يُدفع له شيء واصل طريقه، وليس نضاله متوقف على دخله الرفيع، أو على رئيس وكرسي بائس!
البرجوازيون الصغار الانتهازيون ليس لهم من مال كبير يحفظهم من السؤال، ولا من موقف متجذر يرفعهم عن الانحدار، ولا من عمق الفكر ما يسمو بهم عن التسول، ولا من عمق الدين ما ينأى بهم عن التجارة بما هو ثمين لا يُقدر بمال!
خسروا الموقف وهو جوهر الشخصية وتراكمها الأخلاقي الرفيع وقدرتها على النمو والتأصيل والتحليل والبقاء الشامخ والنقد الشجاع الذي لا يطلب مكأفاة ولا رعاية من لصوص، ولا تقدير من الحقير ذي الجاه والمال.
انتهازيةُ التحديثيين
تعددت علاقات فئات البرجوازية الصغيرة بالإقطاع وهي تعتمد على طبيعة العصر ونمط الإنتاج. حين نقرأ كيف يتدهور وعي هؤلاء ويتراجعون من الحداثة إلى المحافظة والطائفية فلا بد من قراءة ثقافة المرحلة، وزمنية الإقطاع السياسي فحين تكون الدولةُ العربية أقوى من نفوذ رجال الدين ممثلي الإقطاع الديني، هنا تكون لديها من الموارد ما يكفي لشراء ذمم هؤلاء وحين تفقدها يلجأون لغيرها.
إن توجه مجموعات و- لا نقول تيارات فكرية سياسية- إلى النفخ في الجماعات الدينية الطائفية بشكل كبير ثم التراخي عن ذلك بسبب قلة الدفع المالي لها من الجماعات الدينية التي صارت هي الممول الكبير يوضح طبيعة التدخلات السياسية الفوقية والأجنبية وحرف هذه الجماعات عن التجذر في أرضها والتغلغل في تحليله ودرسه وكتابة بحوث وبرامج مؤصلة لقضاياه.
إن هذا الوعي المسطح التجهيلي يقود الناس للكوارث، سواء في اختياراتهم التشريعية أم في نضالاتهم اليومية المجمدة عموماً، ولهذا فإن مبدأية التحديثيين وتوجههم لنشر الخيارات الفكرية الوطنية والديمقراطية والتقدمية غدت طوق النجاة.
أثبتت المرحلة خطورة الانتهازية والكوارث التي سببتها والحصاد المالي الشخصي لبعض قياداتها التي لعبت على الحبال واختارت الدوائر الرسمية وعطائها فكانت مع الطائفيين ساعة صعودهم ومع المال والنفوذ ساعة قوته.
ونجد في انتقالاتها الجغرافية والحياتية والعملية غياباً لأي وعي متجذر وما هي سوى شعارات زائفة كتحبيذ الاشتراكية والدعوة إليها وأصحاب الدعوة همهم جمع المال!
وما تزال قواعد هذه الجماعات غير قادرة على النقد وطرد الانتهازيين من صفوفها وما تزال تعطي لهذه الوجوه المتراقصة على الحبال السياسية مكاناً مهماً.
وهكذا نرى الأشكالَ الاجتماعية من البرجوازية الصغيرة كيف تتذبذب حسب تدفق البحر الاجتماعي، فحين تكون الدولة العربية قوية وذات موارد وتجزل لهم العطاء يؤيدون الكل التحديثي من التطور، ويعادون الموجات الدينية، حتى إذا بدأت الموازين تختل وضعفت مواردُ الدولة العربية وتفاقمت أزماتُها انتشر الجرادُ الطائفي يأكلُ الحقولَ ويشيعُ القحطَ في الحياة وراحت هذه الفئاتُ نفسها تصعد يافطات مختلفة، تؤيد العودة للوراء وهدم التطور الوطني والحداثة والعلمانية.
وإذا كان الجماعات الدينية القديمة قد فككت الجماهيرَ العربية وقسمتها إلى فسيفساء وأهلتها للسيطرات الأجنبية فهذا ما يقوم به الطائفيون المعاصرون وتوابعهم من البرجوازيين الصغار الانتهازيين المتذبذبين، الذين وجدناهم في مرحلة يرفعون شعارات الثورات العمالية الحمراء والبندقية وسحق الأديان ولا يحللون أزمات الدول وعدم ضبطها للتطور والقيام بإصلاحات جذرية لصالح الجماهير العربية منساقين مع التدهور العام في وعي هذه الجماهير مكرسين التخلف فيها.
في الزمن الراهن كذلك يتصاعد الشكلُ اللاعقلاني من الوعي والتطور، فلا تعرف الجماهير كيف تغير، وتتدفق جماهيرٌ متخلفة في الدرس والعمل على المدن وتطرح مستويات فهمها المتخلفة.
وتقود هذه المعارضات وطرح البرامج المحافظة إلى انقسام الناس وتأييد الفوضى وعدم التوحد، وتتوجه فئات البرجوازية الصغيرة لتأييد الصاعد الذي يزداد طائفية وتخلفاً وتفكيكاً للصفوف والعودة للوراء.
هكذا تنقسم النقابات والمعارضة والأشكال التوحيدية في العمل السياسي وتتوجه فئاتُ البرجوازية الصغيرة لتأييد اللاعقل في المعارضة أو الموالاة، ويغدو الإقطاع الديني هو الأقوى ولهذا نرى الاقسام بين الدول الإسلامية بمنحيين، طائفيين رئيسيين خطرين متصادمين.
ويغدو الخروج من العصر الحديث وتمزيق البلدان ونشر الفوضى والتخلف والحروب هو البرنامج الحقيقي لهؤلاء الذين يركبون الموجات ولا يقدمون حفراً عميقاً في الحياة ولا يضحون بل يريدون الناس هم الذين يضحون من أجلهم. ومن هنا نجدهم يقيمون علاقات مشبوهة مع كل الجهات حسب الفوائد التي يجنونها.
انتهازيةٌ نموذجيةٌ
منذ أن أخطأ بعضٌ من أفراد الجيل الوطني القديم في التحالف مع الطائفيين، نظراً لهشاشة جذورهم الفكرية السياسية العلمانية الوطنية، والأعشاب الضارة تتالى من هذا المنبت.
قام الجيل بتضحياته ومغامراته وكان من الضروري نقده، لكن الحالة النموذجية الانتهازية رغم تكرارها لأهمية العقلانية والهدوء التحليلي وبعد النظر تروح تصرخ هائجة وتحيل الموقف وتشريح الجيل القديم لحالةِ تشنجٍ شخصية بدلاً من تطبيق تلك المفردات الكبيرة في الموضوعية والعلمية لكون القائل الناقد لا يعجبها ولا يقترب من مستنقعها وانتهازيها.
ويمكن أن يستفيد بعض المتعلمين من خلفياتهم السابقة، ويتلاعبوا أكثر بقضايا النضال بدلاً من تجاوز الجيل القديم الذي لم تتح له فرص الدراسة الأكاديمية.
خلطهم بين العمل السياسي والدين يغدو تلاعباً، فهم من المتعبدين ومن الانتهازيين. فأي جهة تجلب مصلحة ذاتية يمكن تسويقها. من حقك أن تصلي لكن ليس من حقك أن تلغي تاريخ التيار الوطني في العلمانية وفصل الدين عن السياسة!
حين يغدو الصراع السياسي الطائفي حالة اشتباك عامة يجري تصويرة كثورة وجر الوطنيين إليه، وحين يفشل يتبدل القناع، وتـُفضل المصلحة الخاصة. ولا تـُنقد هذه الأخطاء وتـُحلل بل تـُترك للاستفادة من غموضها!
حتى كوارث الشعب العارمة لا تنجو من الفلتر المصلحي الذي يقضم بعض خيراتها رغم الضحايا والكوارث!
كتاباتٌ هزيلة تستفيد من أي موقع، ويهمها التراكم المالي لا النقدي، لا تقوم بتجذير أي تحليل، وتحاول التقليل من شأن الكتابات الوطنية التقدمية وتخريب حتى أسماء أصحابها والتصغير من نتاجاتهم والتعتيم على وجودهم بأشكال صبيانية.
هذا الحقد نتاج تضخم ذاتي وإعطاء هذه الذات الهزيلة فكرياً مقاماً رفيعاً، فهي يجب أن تكون القائد الأول والزعيم المعترف به رغم الهزال الفكري والتلاعب السياسي وغياب النتاج الموضوعي الدارس للبنى الاجتماعية والصراعات الطبقية.
تخريب التيار هو جزء من المصلحة الذاتية فكلما كثر العميان المتخبطون في الليل السياسي كلما وجدت هذه الذات فرصاً للتلاعب بمصير الوطن والناس.
هي جزء من هذا الخراب الذي أمتد عقوداً وهو خريف اليسار حيث لا جدل عميق ولا شخصيات تؤصل الماضي وتصعد بإنجازاته، فهي مشغولة بمنافعها واستغلالها للماضي والحاضر، أو هي جامدة لا تقرأ وتدرس.
قوانين الانتهازية
للانتهازية سواء كانت يسارية أم يمينية، علمانية أم دينية، في السلطة أو في المعارضة، قوانين مشتركة.
وقد عمل الانتهازيون في صفوف اليسار طويلاً لعدم توحده، ولتضارب شخوصه ورموزه وقواعده، ولعدم إنتاج فكر مستقل له، بهدف عدم وجود قوانين موضوعية لفكره ولكيانه على الأرض تحاسبهم، وبالتالي يمكنهم التحرك واستغلال تلك القواعد المهلهلة، لمصالحهم الشخصية.
وهكذا هم اليوم يتعكزون على الدينيين أو على جماعات صغيرة شخصية وعديمة الوعي، من أجل وصولهم لكراسي السلطة بشتى أنواعها، وللثروة. فذلك النخر داخل الحركة اليسارية لإطفاء جذوة وعيها وعدساتها الضوئية الاجتماعية، من أجل حركتهم الفردية، وسطوتهم، وعلامات هؤلاء الفارقة هي الغرور والتضخم الشخصي وبث العداوة بين اليسار وربطه بالقوى المحافظة السياسية والدينية وقطف ثمار الثروة.
وهذا ما يقوم به الجيل الجديد من الانتهازية داخل الحركات الدينية، فهو يصعد على تضحياتها، وقواعدها، ولا يقوم بكشف قوانين الثقافة الإسلامية، عبر درس تجربتها، وأسباب انهيار حضاراتها، وتناقضات حركاتها، وكيفية توحدها بالجماهير العاملة، من أجل أن تظل القواعد عمياء، والتنظيمات بلا قوانين ديمقراطية، ولا يتم التفريق بين المضحين والشهداء وبين اللصوص.
إن انتهازيي اليسار يريدون أن يصعدوا إلى البرلمان والسلطة دون تيارات قوية على الأرض، يضحون من أجل زرعها وتكوين عقليتها الديمقراطية بل لعبوا دوراً كبيراً في تمزيقها، فيتعكزون على تضحيات غيرهم، الذي لا يوصلهم إلا بشروط هي أن ينكروا وعيهم اليساري، ويصيروا أفراداً لا يعبرون عن فكر.
وبين انتهازيي اليمين الديني وأولئك علامات مشتركة، هي أن الانتهازيين في الحركات الدينية وقد استندوا على قواعد منتفخة كماً، عاطلة من الوعي كيفاً، يحبذون هذا النوع من الانتهازية اليسارية، فالدم واحد، وهم يقولون لقواعدهم نريد مثل هؤلاء الذين يعطلون قوانين الوعي والديمقراطية، وهم يعيدون إنتاج هذا النمط داخل حركاتهم، لأنهم غير قادرين على إنتاج ثقافة إسلامية ديمقراطية، تفترض الوحدة والعودة لجذور النضال الموضوعية والاستناد على حركة الجمهور المنظم المسئول السائل.
وكما عانت حركة اليسار من الانتهازية في صفوفها فسوف تعاني الحركات الدينية من الانتهازية في صفوفها سواءً بسواء، فهؤلاء يضعون نظاراتهم المكبرة على الكراسي والثروة، ولم يكن لديهم إنتاج فكري يحدد خطواتهم على الأرض، وبالتالي تغدو حركاتهم دائماً ذاتية كيفية اعتباطية، بلا دستور يؤطرها، ولا قانون يضبطها، ولا قواعد تحاسب عليها.
ولهذا تعتمد الحركات المصنفة بهذا الشكل على عدم خلق النتاج الفكري المؤطر المـُنتج بشكل طليعي والمُناقش بشكل جماهيري بل تعتمد على فلتات الزعيم دام ظله.
فهم يومٌ في أقصى اليسار وهم يومٌ آخر في أقصى اليمين، فلماذا جرى هذا الانتقال العنيف؟ وأين ذهبت التضحيات وكيف ضاعت ساعات العمل والجهود والزمان فهذا كله لا يهم والمهم أن الزعيم جاءته علامة، وحضرت له خاطرة بارقة عظيمة، فحول مسار القطيع.
وهذا الأمر نفسه في الدولة، فالانتهازية موجودة في كل مكان، والانتهازيون الحكوميون لا يريدون أن تكون للدولة قواعد، تحدد تقاسم الثروة وكيفية إجراء المناقصات وكيف تـُحدد الميزانية بشكل علمي وكيف تنـُاقش بشكل شعبي، ولا يريدون أن تـُعرف دخول الشركات وأين تذهب، وأن يظل هناك الخيط السري لتوزيع الثروة للبعض، وهم مثلهم مثل بقية الانتهازيين يقودون المجتمع للهلاك في سبيل صالحهم.
تتفق هذه القوى كلها على إبقاء لعبة السياسة في أيديها، وكيفية توزيع الأدوار بينها، وتغذية بعضها بعضاً، وفي النهاية يبقى العمال عمالاً ومحدودي دخل بينما يصعد الانتهازيون ويحصلون على الفلل والبيوت والأرصدة ويذهبون للمؤتمرات ويصدرون الكتب عن إنجازاتهم ونضالهم الكبير من أجل الجماهير!
الانتهازية والموضوعية
من الصعب أن يكون الانتهازي موضوعياً، فهو يرى الجهة التي يستفيد منها كأعظم الجهات، والجهة التي يخسر منها كأسواء الجهات، ولهذا لا يرى أي جانب إيجابي في الجهة التي تعارض مصلحته، ولا يرى أن الجهة التي يستفيد منها تسبب الأضرار للآخرين.
وحين تصبح المصلحة الذاتية مُسيرةً لوجهات النظر الفكرية والسياسية، يتشابك الذاتي والموضوعي، وتضيع الحقيقة !
ولهذا حين تصطف جمعيات عديدة مع الدولة لأنها تستفيد منها، وتختفي لغة النقد الموضوعي منها، حيث إذا رأت شيئاً سلبياً من الدولة صمتت، وإذا رأت شيئاً إيجابياً اندفعت تلهج بالمكاسب والمآثر.
وعلى العكس حين ترى شيئاً إيجابياً في الخصوم تسكت، ولا تشير إلى هذا الإيجابي وكأنه لم يكن، وحين ترى شيئاً سلبياً تندفع لإصدار البيانات والتصريحات.
بطبيعة الحال هم يستخدمون هنا لغة تتظاهر بالموضوعية، والصدق والوطنية، والحفاظ على مصالح الشعب العليا وضرورة رؤية التقدم والتسامح الخ..!
وتفعل الجمعيات الأخرى ذات الأمر ، وتتبع نفس الخط، ولكن لمصلحة مختلفة. فإذا قامت الدولة بشيء إيجابي سكتت، أو تحدثت عن النواقص الكبيرة في هذا الإنجاز، وتصبح أحياناً التحولات المهمة في الحياة السياسية بعد عقود الجفاف وكأنها تخلو من أي شيء إيجابي في المسائل المفصلية للحياة السياسية.
وحين يقوم أصدقاؤها بأعمال ما ترفعها إلى السماء، ولا تشير إلى أي جانب سلبي، وخطر على الحياة السياسية والاجتماعية، وكأنها تقدم هؤلاء كأنهم حملان أو غزلان، ولا ترى عمليات التحشيد السلبية أو تراكم الجهل في الجمهور وعدم تبصيره بالحقائق عن هذه الظواهر، فقط لأنها ظواهر صديقة، فصديقي منفوخ كالبالون وعدوي مخسوف إلى أسفل سافلين !
إن الرؤية الذاتية هنا، سواء عند مناصري الدولة الأشداء أو خصومها الأشداء، لا تنتج حالة سياسية وثقافية صحية، ولا تكون وعياً موضوعياً يتراكم عند الناس، بل تقوم على ثقافة الشحن الانتهازية التي لا تتبصر الطرق ومنعرجاتها القادمة، ويقودها سائق مسرعٌ لا يفكر سوى بالوصول إلى وجبته الساخنة، ولا يهتم بالمارة وإشارات المرور !
ولكن يظهر من هذه الحالات الذاتية المصلحية أناسٌ يتبصرون بموضوعية الأشياء، ويغدون أكثر حكمة وعقلاً، ويقومون بتغيير زوايا رؤيتهم ويكتشفون في خصومهم نقاطاً إيجابية، وفي أصدقائهم نقاطاً سلبية.
وعلى مدى نشاط هؤلاء الموضوعيين وتجميعهم للقوى السياسية، وتركيزهم على السلبي أياً كان مصدره، والإيجابي أياً كان منفذه، تتوقف العمليات السياسية والفكرية والتغييرات واتجاهها.
وكلما أزداد عدد هؤلاء في مختلف الجمعيات والتيارات وناضلوا بجرأة من أجل الموضوعية الفكرية والأمانة السياسية، كلما ترسخت خطوط العقلانية والدفاع عن المصلحة العامة، ويزداد انحصار أولئك الذين يكرسون مصالحهم الخاصة، باعتبارها هي الوطن والحقيقة والمستقبل.
لكن هؤلاء الذاتيين المصلحيين ليسوا ضعافاً، بل هم أقوياء، ويستمدون قوتهم أساساً من تفكك الموضوعيين وأصحاب النزاهة، ومن قلة المدافعين عن المصلحة العامة بشكل مستقيم وكلي، لكن النضال السياسي يعتمد على التغلب على هؤلاء بأدوات الوضوح والكشف والتعاون بين مختلف العناصر النزيهة.
إن الانتهازية تتكشف عبر التحليل الواسع والموضوعي وعبر النضال المشترك لتعرية الأقنعة المختلفة.
أسباب الانتهازية في اليسار
تعود أسباب انتشار الانتهازية في اليسار إلى عجزه الفكري عن التحليل، وفي الحياة السياسية تمثل تلك انتهازية من قبل القوى القيادية فيه، لمشاركة قوى الاستغلال في شيء من غنائم المال العام.
وهكذا يتم غض النظر عن جوانب والتركيز على جوانب، بهدف إظهار حسن النوايا سواء للإقطاع المذهبي أو السياسي، بحيث تبدو وجهة النظر المساقة متفقة مع نضال الشعب والديمقراطية والوطنية الخ، لكن من يطلقها يحسب حساباً طبقياً استثمارياً فهو يهدف لخدمة مصلحته.
حين يهاجم الدينيين بقسوة فهو يقصد هنا إظهار نفسه تحديثياً رسمياً وإنه يصلح للارتفاع إلى مقام الموظفين الكبار، وحين يهاجم الرسميين بقسوة مماثلة يريد مغازلة الدينيين لكي يصعدوه إلى مراتبهم العلية.
وتتشكل هنا أقسام جزئية أخرى داخلية ضمن هذا التعدد السياسي والطائفي المتنوع، فهذا يغازل طائفة وآخر يغازل طائفة وثالث يغازل جناحاً في السلطة وآخر يغازل جناحاً آخر، وخامس يغازل جناحاً في الجماعة المذهبية المنشقة وهكذا دواليك يقوم هؤلاء بجرنا إلى الخراب الطائفي..
وبدلاً من نشر الوعي الديمقراطي بين الناس كوعي أساسي يجري نشر الوعي الشمولي وتغليب العناصر الانتهازية..
إن الذين أيدوا إنجازات التحولات نسوا سلبياتها لأنهم قبضوا ثمن السكوت عن السلبي وركزوا على الإيجابي..!
والذين ركزوا على السلبي سرعان ما قفزوا لاستثمار إيجابياتها دون ذكر هذه الإيجابيات، لأن الجمهور الذي صنعوا وعيه على كراهية النظام لا يستسيغ مثل هذه القفزة البهلوانية!
وهو إذ يريد معارضة السياسة السائدة يريد تحولات في رواتبه ومساكنه وأحجام عمالته، لكن الذين يتسلقون على نضاله ومشاعره يريدون الوصول لأهدافهم الخاصة مع بعض البهارات النقدية.
وإذ استطاعت قوى اليمين أن تزيف تحركاتها الاستغلالية تحت غطاء كثيف من البخور الديني، لكن قوى اليسار تاهت ووضحت انقساماتها القائمة على الأهداف الذاتية، فشاركت في التقسيم الطائفي وتعميقه بين فئات الشعب المختلفة.
وصار الوصول للكراسي بديلاً عن إنتاج ثقافة سياسية ديمقراطية تحديثية توزع على كافة السكان، لأن التقلبات في السيرك السياسي كانت كبيرة لا تتيح خلق وعي، فيظهر موقف حاد ثم يعقبه موقف مناقض، ولا تردم الهوة بين الموقفين من خلال مواقف عقلانية صبورة في كل المواقف.
وهذا كله يفتت جبهة المعارضة وجمهورها الذي يبدأ بالانحسار والتشتت والتمزق وربما التضارب مستقبلاً!
وظهر هناك اتجاهان أساسيان في اليسار الاتجاه الأول هو اتجاه انتهازي، ويتوجه لدعم اليمين الديني، مقابل رشوة سياسية، واليمين الديني أثبت خواء تجربته السياسية سواء لدى المقاطعين أم المشاركين، بل وخطورة تسيده على القوائم والكراسي، لما يقود إليه من أخطار.
والاتجاه الثاني حائر متصارع متذبذب، بين حدة في الهجوم على التيارات الدينية اليمينية، وبين الخشوع لهجومها الخطر على التقدم الوطني.
والاتجاهان يكملان بعضهما، وهما نتاج خطة خفية مشتركة، تمهد الدروب للمتطرفين الدينيين لكي يتقاتلوا ويخربوا..
ضعف اليسار وانتشار الانتهازية
وهاتان السمتان تمثلان وجهي العملة، فقوة اليمين المذهبي تستندُ إلى ضعف اليسار وضعف اليسار يقود إلى قوة اليمين الطائفي بفصائله المختلفة.
والفئاتُ الوسطى المرتكزة على هذا الوعي اليميني المنتشر تقود بالضرورة إلى التهاون في قضايا العمال والموظفين عموماً، فالوعي المذهبي السياسي غير ملتزم بأي برنامج لمصلحة الشغيلة، وهو عبر هذا الغموض الاجتماعي يصَّعدُ بعض افراده لحيازة المكاسب.
إن الوعي المذهبي السياسي كوعي انتهازي عميق يحتاج إلى مثل هذا الغموض لعدم الارتباط بالقوى الشعبية وتغيير أوضاعها الاجتماعية، ولبقائها في خدمته.
ويجرى هنا استغلال الإسلام لخلق مثل هذا الدخان الاجتماعي لتصعيد الانتهازيين.
وبالتأكيد يجرى ذلك عبر الطائفية وليس عبر التوحيد الإسلامي.
فنحن نتمنى أن يسيروا على درب عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب في مكافحة الاستغلال، ولكن على من تقرأ مزاميرك يا داود؟
والطائفية بحد ذاتها إعلان عن توسع تمزيق الشعب وتوسيع هذا التمزيق إلى مستويات سياسية عليا.
وضعف اليسار هو الوجه الآخر لقوة اليمين، فاليسار بذيليته لقوى الطائفية، قام بتمزيق صفوفه، لعدم قدرته على الارتقاء إلى مهمات الإسلام التوحيدية، والوطنية، والإنسانية، وتبعيته للطائفيين.
وتمزيق صفوفه تشكل لملاحقته الشعبية السطحية لهذه القوى، وبدغدغة عواطف الجمهور الجاهل بمصالحه، الذي يقود نفسه للكوارث، كما تشكل ذلك بالضعف التنظيمي الداخلي والصراعات الذاتية، التي شكلها أفرادٌ مرضى معقدون منفصمون عن معارك الناس، ومهووسون بذواتهم الفارغة المريضة. إن طرد هؤلاء من صفوف اليسار صار مهمة ملحة للقواعد بأسرع وقت ممكن.
ومن هنا فالوعي الوطني الذي علامته البارزة هو اليسار في هذه المرحلة والمرحلة السابقة، لم يجد ممثلين بارزين له. ومن هنا ستتواصل اللعبة الذاتية في استخدام قضايا الناس لتعبئة الجيوب.
كما يتضح ذلك في ضخامة أعداد المستقلين، الذين لم يحسموا الخيار التاريخي بالصراع الوطني ضد الطائفيين وضد الاستغلال على أغلبية الناس والعاملين؛ والذين يتمسحون بأذيال الطائفيين لتصعيدهم إلى الكراسي، وليس في نضالهم من أجل مصالح الجمهور، التي تترابط مع النضال الوطني ومع قيادة اليسار في هذه المرحلة من التاريخ.
وأقول اليسار لأن الفئات الغنية العليا صمتت عن الكفاح خلال العقود السابقة، ومن يحمل خطها الآن في المعركة، لم يثبت موقفه بشكل ملموس ومتجذر في الأرض.
ومن الواضح أن قوى التضحية تضعف مع ضخامة الجهل الشعبي، ولهذا فمن الصعوبة في هذه المرحلة هزيمة القوى الطائفية، لكن يجب عدم الاعتماد عليها حتى في هذه المرحلة؛ وبضرورة عدم خداع الناس بأن هؤلاء سيفعلون أشياء مهمة؛ والخوف أن يفجروا معارك مجانية داخل البرلمان، فنرجو أن يواصلوا التعقل الذي بدأوه مؤخراً بالركون للوحدة الوطنية والنضال السلمي الداخلي المتأني. وتتضاعف المسئولية في الخليج مع طرح الملف النووي الإيراني وما سوف يحدثه من كوارث على المنطقة.
إن ظهور برلمان وطني توحيدي يكرس نفسه للولاء الوطني ولا يكون تابعاً لقوة سياسية خارجية يصعد الأزمات والصراعات تبعاً لريموت كنترولها، هو الخندق الأساسي الذي يجب أن نصطف فيه، مدافعين عن التطور الديمقراطي الداخلي في أي بلد، وبضرورة رفض التدخلات الأجنبية وإعطاء الشعوب حقوقها كذلك.
إن مهمات النضال الوطني التوحيدي ومعالجة المشكلات الكبيرة من تدني الأجور وسياسة سيادة العمالة الأجنبية وضخامة تلوث البيئة وعدم وجود تخطيط عمراني — اقتصادي متكامل الخ، ان كل هذه المهمات وغيرها يجب أن تكون بؤرة عمل البرلمانيين. لكن توجه المذهبيين السياسيين هو توجه طبقي بخدمة شرائح صغيرة في المجتمع.
الانتهازيون والفوضويون
مع غياب التيارات العقلانية الوطنية الديمقراطية انفتح الباب للفوضويين والانتهازيين للسيطرة على الساحة العقلية المعطلة للجمهور.
انتشار الوعي الديمقراطي توارى بسبب هذا الكم من الفوضويين والمسعورين سياسياً والحمقى فكرياً، فهؤلاء كانت مهمتهم الحقيقيةخلال سنوات عديدة سابقة هي تخريب ساحة النضال، ففي أيام العمل السري كان تجنيد الأعضاء ودفعهم في معارك غير متكافئة، وجر الشباب لأعمال تفوق فهمهم، وكان شعارهم (اعترفْ وأخرجْ من السجن) مما صحر القواعد وغيّب المناضلين والتراكم الديمقراطي والتماسك النضالي والصلابة السياسية والأفق الفكري المنفتح.
أعتمد هؤلاء على لغة الصراخ والانفعال الشديد مما جعل سياسة الحماقة هذه تولد(قادة) فوضويين عنفيين كل قدراتهم تكمن في الصراخ وعدم فهم الواقع والمستقبل، مما أدى إلى انتشار مدرسة الحماقة هذه خاصة في الجيل التالي الذي أجدب يسارياً ووطنياً ووسع من الدينيين الطائفيين الذين أوصلوا هذه الحالة للذروة، وقسموا المجتمع، وهدموا الفكر والتطور.
ما زال هؤلاء المغامرون الفوضويون يحكمون الصفوف الأولى في الجماعات السياسية، ويكرسون نهج الحماقة حتى بعد أن أُصيب الجيل الأول بالخيبات والاختفاء والهزائم.
هذا صّحر الواقع السياسي من الوعي، ومن رؤية المستقبل والانضباط العقلاني السياسي، وجعل الجملة الحادة الصاخبة، واستعمال الأيدي والألفاظ البذيئة والادعاءات السياسية المراهقة حتى في البرلمان بديلاً عن العقلانية والتراكم السياسي الطويل وتكوين الجماعات المعتدلة المتنفذة ذات المشاريع السياسية وفهم مشكلات الجمهور والبلد والمساهمة في حلها.
هذا مكن الانتهازيين من جهة أخرى من فرش نفوذهم في الواقع السياسي المريض، فهؤلاء لا يملكون أي وعي وأي رغبة في إصلاح المجتمع بقدر ما يسعون لتكوين مصالحهم الخاصة وتكوين شلل الفساد العامة الخاصة.
وقد حصلوا على فرصهم مع غياب العقلانيين والوطنيين المخلصين بعيدي النظر وأصحاب البرامج والثقافة السياسية العميقة فعطلوا البرلمان والصحافة والوعي عامة.
وهكذا بدلاً من دحر الفوضويين واستخدام ما في خطاباتهم من نواة عقلانية وفرزها عن الفوضى والصخب والعنف الذاتي، يقومون برفض كلَ شيء وعدم طرح البديل وعدم التعبير عن مشكلات الناس والمجتمع، مصورين أنفسهم بأنهم دعاة العقل وليس قوى الفساد السفلى المشاركة القارضة للمال العام.
تقوم الفوضوية والانتهازية بدور متكامل مشترك وهو منع الوعي السياسي الناضج من التكون ومن تشكل قوى الإصلاح الشعبية، وتحولها لتيارات مؤثرة.
وبهذا يفقد الجمهور أمل التغيير، وينتشر فيه اليأس ويفرز ذلك قوى التطرف والعنف والجريمة.
بدون النقد وتكوين البديل الإعلامي وطرح النماذج السياسية المركبة الجامعة للنقد والمسئولية التعبيرية والحكمة العملية، فإن هذه النماذج المخربة للعمل السياسي الوطني سوف تنتشر وتمنع التطور مستفيدة من الفوضوية والمراهقة السياسية.
تفكك الثقافة الفاعلة
حين نرى المسار المؤلم للجماعات التحديثية التي بدأت حادة مخيفة في أطروحاتها ثم انتهت وهي تبحث عن المال بأي صورة، لا بد أن نقوم بدرس ذلك، فهو مسار معقد وقد يتكرر لدى المجموعات الدينية كذلك وربما بطريقة أكثر حدة وتعقيداً.
لنلاحظ ان الاهتمام بالأشكال والجوانب التحديثية المفصولة عن مضمون تغيير أحوال الناس، أي الاهتمام بالأنا على حساب النحن، وكذلك لغة الهجوم الحادة على الإرث والتقاليد وتوجيه المجابهة بين قوى المعارضة، تماثل الطرح قبل عقود أن حل كل المشكلات يمكن عبر البندقية ولغة النار.
ولكن مجموعات الفئات الوسطى المعبرة عن تجربة أقصى اليسار، كانت وهي تدفع ثمناً باهظاً من حياتها لمثل هذه الأفكار، لم تتعلم منها أثناء التجربة، وإذا غدا الحرمان مكروهاً، وتطوير وعي الذات الحزبية بالواقع وبالفكر غير ممكن لأسباب كثيرة، لهذا كان الاتجاه نحو النقيض، نحو المال والمراكز والشهرة والصداقة مع الأنظمة والحركات الشمولية ومع المهيمنين بشتى ألوانهم، والمهم خدمة الأنا.
كان هذا الإفلاس الفكري يتجلى بالوقوف عند المرتكزات الشمولية للنظام الشمولي القديم، (الاتحاد السوفيتي، والصين وكوبا) أو بالارتهان كلياً للتجربة الغربية، وتأتي عدم القدرة على فهم النظام العربي التقليدي الراهن، وتشجيع الأنظمة كذلك لانفتاحية الفئات الوسطى، في التوجه للانتهازية اليمينية هذه المرة، أو التشدق بألفاظ اليسار عبر جمل باترة وامضة؛ مع غياب الموقف التوحيدي لليسار والقوى الديمقراطية عامة..
إن هذا ينطبق على انهيار أنماط الوعي المستخدمة، كغياب الدراسة العلمية، وتخثر الشعر، وجمود القصة، وشكلانية اللوحة التشكيلية وموتها، وسفر الأغنية الثورية إلى الصمت والتجارة، وانتهازية القانون حسب مواقف الجماعة الخ..
إن العجز العميق عن التطور يولد أمراض جنون العظمة، وتشجيع الشلل لتخريب الثقافة الوطنية ومعاييرها الموضوعية، وتكريس النجومية وحب المال، وتفكيك الجماعات اليسارية والوطنية عموماً.
إن الخراب كان كبيراً في العمق، وهو خرابٌ غير مدروس، وغير معروفة آثاره، ولكن ظاهرة العجز عن الفعل، وتكرارية اللغة الميتة، والعودة للمأتمية، والاصطافات اللامبدئية، والعجز عن النقد العميق، هي وغيرها تشير إلى تخثر فعل ممثلي هذه الفئات الوسطى، وعجزهم عن العمل الاجتماعى الفاعل.
ومن هنا نجد أن الثقافة الرسمية السائدة في بعض الدوائر تشجع على كل ما هو منقطع عن الموقف المبدئي، والاحتفاء بالخارج، ولهذا فهم يشجعون ثقافة من موزمبيق لكن لا يمدون ايديهم للمنتج المنهار المحلي، إلا إذا تخلى عن ثقافته الوطنية المنتجة وتحول إلى أراجوز سياسي أو شعري أو تشكيلي أو مسرحي، فالمهم هو الاستعراضات.
لغد قامت القوى (التحديثية) بتقزيم بعضها بعضا، فتلك الجماعة تحتكر أغلب جوانب الثقافة المفيدة المدرة للأرباح، ولكن إلى ماذا قاد ذلك؟ إلى التخلي عن نقد الواقع، وعدم قدرة النتاجات ان تعري الأخطاء، وهذا الجانب لم يتغير حتى بعد أن أخذت الدوائر الرسمية تنقد نفسها. وتغدو التحالفات غير مبدئية، فالسياسي الذي ينقد بقوة وحِدة الواقع السياسي، يصمت عن نقد الواقع الثقافي الفاسد، فلم يمتلك منهجين مختلفين؟
February 12, 2023
اÙاتجاÙات اÙ٠ثاÙÙØ© Ù٠اÙÙÙسÙØ© اÙعربÙØ© اÙإسÙا٠ÙØ© Ùتب ع٠ر ÙÙØ´
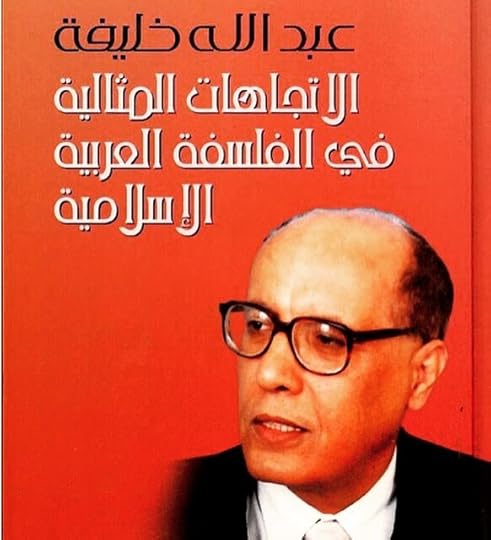 اÙاتجاÙات اÙÙ
ثاÙÙØ© Ù٠اÙÙÙسÙØ© اÙعربÙØ© اÙإسÙاÙ
ÙØ© اÙجزء اÙØ£ÙÙ ÙاÙثاÙÙ
اÙاتجاÙات اÙÙ
ثاÙÙØ© Ù٠اÙÙÙسÙØ© اÙعربÙØ© اÙإسÙاÙ
ÙØ© اÙجزء اÙØ£ÙÙ ÙاÙثاÙ٠اÙاتجاÙات اÙÙ
ثاÙÙØ© Ù٠اÙÙÙسÙØ© اÙعربÙØ© اÙإسÙاÙ
ÙØ©
Ù
ؤÙÙ Ùذا اÙÙتاب Ù٠عبداÙÙÙ Ø®ÙÙÙØ©Ø Ø§ÙÙاتب ÙاÙرÙائ٠اÙبØرÙÙÙØ Ù٠اÙعدÙد Ù
٠اÙأعÙ
ا٠اÙرÙائÙØ© ÙاÙدراسات.
ÙÙÙ Ùتاب٠«اÙاتجاÙات اÙÙ
ثاÙÙØ© Ù٠اÙÙÙسÙØ© اÙعربÙØ© اÙإسÙاÙ
ÙØ©Â»Ø ÙØاÙÙ Ø®ÙÙÙØ© تÙÙ
س ظاÙرات اÙÙع٠اÙعرب٠٠اÙإسÙاÙ
٠بجاÙبÙ٠اÙأساسÙÙÙ: اÙدÙÙ ÙاÙÙÙسÙØ©Ø ÙبجذÙر Ùذا اÙÙع٠اÙØ£ÙÙÙØ Ø§Ùت٠تÙ
تد Ù
Ù Ù
رØÙØ© اÙجاÙÙÙØ© ÙظÙÙر اÙإسÙاÙ
Ø Ø«Ù
تشÙ٠اÙدÙÙØ© اÙإسÙاÙ
ÙØ©Ø ÙصÙÙا٠إÙÙ ÙÙاÙØ© اÙدÙÙØ© اÙØ£Ù
ÙÙØ©.
ÙÙØ£Ù
Ù Ù٠أ٠ÙØÙ
٠عÙ
Ù٠رؤÙØ© جدÙدة Ø¥Ù٠«اÙÙع٠اÙعربÙÂ»Ø Ø§Ùذ٠بدأ Ù٠اÙظÙÙر بصÙØ© ÙØ«ÙÙØ©Ø Ø«Ù
اÙØاز Ø¥Ù٠اÙطبÙعة اÙدÙÙÙØ© اÙتÙØÙدÙØ©Ø ÙÙ٠أÙ
ر غÙر Ù
عزÙ٠ع٠إطار٠اÙتارÙØ®ÙØ Ùع٠بÙÙت٠اÙاجتÙ
اعÙØ© اÙخاصة اÙت٠ÙÙÙÙ
بتÙÙÙÙÙØ§Ø Ø¬Ø¯Ùا٠Ù
ع اÙتارÙØ®Ø ÙØÙرا٠Ù٠اÙØاضر.
Ùذا اÙÙ
ÙضÙع اÙÙØ§Ø³Ø¹Ø ÙغÙر اÙÙ
ÙÙØ¯Ø ÙتطÙب اÙترÙÙز عÙ٠بÙÙØ© ÙÙرÙØ© ÙاجتÙ
اعÙØ© Ùاسعة ÙÙ
Ù
تدة ÙÙ
تØÙÙØ©Ø ØªØ´Ù
٠جÙ
ÙØ© اÙØ£ÙÙار اÙت٠ÙاÙت سائدة Ù٠اÙÙ
جتÙ
ع اÙعراÙ٠اÙجÙÙب٠اÙÙدÙÙ
Ø ÙعÙ٠اÙخطÙØ· اÙعرضÙØ© ÙتطÙر اÙÙع٠اÙدÙÙÙ ÙÙ Ù
صر اÙÙرعÙÙÙØ©Ø ÙاÙتشا٠طبÙعة اÙÙظاÙ
اÙاجتÙ
اع٠اÙت٠ÙاÙت سائدة ÙÙØªØ¦Ø°Ø ÙتبÙا٠دÙر Ø°Ù٠اÙÙظاÙ
اÙاجتÙ
اع٠Ù٠اÙتطÙر اÙتارÙØ®Ù.
Ø°Ù٠أ٠اÙÙع٠اÙعربÙØ Ø¨Ù
عÙاÙا اÙإجرائÙØ ÙÙ
Ù Ø«Ù
تطÙر٠اÙÙاØÙ: اÙÙع٠اÙإسÙاÙ
ÙØ ÙÙÙ ÙÙÙ
٠داخ٠بÙÙت٠اÙاجتÙ
اعÙØ© ÙÙÙÙ
باستعادة تÙ٠اÙعÙاصر Ù
٠اÙعصÙر اÙÙدÙÙ
Ø©Ø Ø³Ùاء عبر عÙاÙت٠اÙÙ
Ø¨Ø§Ø´Ø±Ø©Ø Ø£Ù Ù
Ù Ø®Ùا٠اÙتأثÙرات اÙÙÙرÙØ© اÙت٠تأطرت Ù
Ù Ø®Ùا٠اÙأدÙاÙ: اÙÙØ«ÙÙØ©Ø ÙاÙÙÙÙدÙØ©Ø ÙاÙÙ
سÙØÙØ©.
ÙÙ٠دراسة اÙبÙÙØ© اÙاجتÙ
اعÙØ©Ø Ø¹ÙÙÙا Ø£Ù Ùا تجع٠اÙباØØ« Ù
أسÙرا٠Ù٠طابعÙا اÙتÙÙÙØ Ø£Ù Ø§Ø¹ØªØ¨Ø§Ø± اÙÙع٠Ù
جرد اتجاÙات٠ÙÙرÙØ© ÙسÙاسÙØ©Ø Ø¨Ù ÙتÙجب اعتبار٠عÙاÙات ØÙØ©Ø Ø§Ø¬ØªÙ
اعÙØ© ÙاÙتصادÙØ© ÙØ«ÙاÙÙØ© Ù
Øددة.
Ùإذا Ùا٠اÙإسÙاÙ
ظاÙرة ÙÙ
ت بÙ٠اÙرعاة ÙÙ٠اÙÙ
جتÙ
ع اÙعرب٠اÙرعÙÙ ÙÙابد أ٠تÙÙ٠جذÙر٠Ù
ربÙطة بÙ
ستÙÙات Ùذا اÙÙ
جتÙ
Ø¹Ø ÙÙÙÙ٠عبÙر Ù Ù
Ù ØÙØ« اÙإتجا٠٠ع٠تØÙÙ Øضار٠ÙتجاÙز Ù
جتÙ
ع اÙرعاة ÙØ°Ø§Ø ÙÙستÙد٠تخطÙØ·Ù ÙتÙ
دÙÙÙ.
ÙعÙÙ٠تتشÙ٠عÙاÙØ© اÙدرس ÙاÙتØÙÙÙ ÙÙعÙاÙØ© بÙ٠اÙÙ
دÙÙØ© (Ù
ÙØ©) ÙÙاعدة ØضارÙØ© ÙÙؤÙاء اÙرعاة. عÙÙ
ا٠أ٠بÙ٠اÙÙÙادة اÙØ·ÙÙعÙØ© ÙاÙجسÙ
اÙاجتÙ
اع٠تتÙÙ٠عÙاÙات Ù
عÙدة Ù
٠اÙتداخ٠ÙاÙتجاÙز.
ÙÙ٠اÙعÙد اÙراشد٠ÙاÙت اÙبÙÙØ© اÙسائدة تستÙد Ø¥Ù٠ظÙÙر Ù
ÙÙÙØ© اÙدÙÙ ÙÙأراض٠اÙعاÙ
Ø© (اÙصÙاÙÙ)Ø ÙظÙÙر ÙÙ
Ø· جدÙد Ù
٠اÙØ¥Ùتاج ÙاÙتÙزÙØ¹Ø Ø§ÙØ£Ù
ر اÙذ٠أÙض٠إÙ٠سÙسÙØ© Ù
٠اÙتغÙرات اÙاجتÙ
اعÙØ© ÙاÙÙÙرÙØ©Ø ÙÙ
ع ترسخ Ùذ٠اÙبÙÙØ© Ùاستعادة اÙÙÙاÙ٠اÙاÙتصادÙØ© اÙعائدة Ø¥Ù٠اÙعصر اÙÙدÙÙ
Ø ØªØ¨Ø¯Ø£ اجتÙ
اعات سÙاسÙØ© عÙ
ÙÙØ© ÙÙ Ùذ٠اÙبÙÙØ©Ø ØªÙض٠إÙ٠اÙÙظاÙ
اÙسÙاس٠اÙØ£Ù
ÙÙ.
ÙعÙÙÙ ÙتÙغ٠خÙÙÙØ© Ù٠دراسة Ù٠بÙÙØ© اÙÙظاÙ
اÙØ£Ù
ÙÙ ÙتÙاÙضاتÙا ÙسÙرÙرة اÙصراعات داخÙÙا ÙسببÙتÙØ§Ø Ø¨ØÙØ« ÙÙÙÙ
بÙضع اÙخطÙØ· اÙعرÙضة ÙتطÙر اÙÙ
جتÙ
ع اÙعرب٠٠اÙإسÙاÙ
Ù ÙÙ Ùذ٠اÙÙ
راØ٠اÙاجتÙ
اعÙØ© ÙاÙسÙاسÙØ© اÙÙ
ØªØ¹Ø¯Ø¯Ø©Ø Ù
Ù Ø®Ùا٠Ùراءة عÙ
ÙÙØ© اÙتÙاÙÙ Ù
٠اÙبداÙØ© Ø¥Ù٠اÙØضارة.
ÙتبÙا٠طبÙعة اÙصراعات ÙأشÙاÙÙا ÙÙ
ضاÙ
ÙÙÙØ§Ø ÙصÙÙا٠إÙ٠دراسة اÙتشÙÙÙÙØ© اÙاÙتصادÙØ© ٠اÙاجتÙ
اعÙØ© اÙت٠استÙر عÙÙÙا. ÙاÙÙ
ÙØ·ÙÙ ÙÙ Ø°ÙÙ Ù٠أ٠تبعÙØ© اÙØ¥Ùسا٠ÙÙطبÙعة ÙÙا ÙعدÙ
ÙجÙد Ùدرات Ø¥ÙتاجÙØ© تØÙÙÙÙØ© ÙدÙÙØ ÙاÙت تÙÙد Ø¥Ù٠سÙطرة اÙÙÙ٠اÙÙ
اÙرائÙØ© اÙÙ
ختÙÙØ©Ø ØªØ¹Ø¨Ùرا٠ع٠اÙجÙاÙب ÙاÙÙÙ٠اÙÙ
ادÙØ© Ù٠اÙÙÙÙ ÙاÙØÙاة اÙت٠تÙÙÙ
٠عÙÙÙ.
غÙر أ٠إÙسا٠اÙعصÙر اÙÙدÙÙ
Ø© Ø£Ùجد اÙرؤ٠ÙاÙشخÙص اÙÙ
تخصصة Ù٠اÙتØÙÙ
Ù٠عÙ
ÙÙØ© اÙØ¥Ùتاج اÙرÙØÙØ ÙØ´Ù٠أÙÙ٠سØر٠Ù
٠اÙÙ
ثاÙÙØ©Ø Ø£Ù Ø¹Ø¨Ùر Ùذا اÙÙع٠اÙØ°Ù Ùعط٠اÙخارج اÙÙ
ÙتاÙÙزÙÙ٠اÙÙدر عÙ٠اÙسÙطرة عÙ٠اÙداخ٠اÙØ¥ÙساÙÙØ Ø³Ùاء Ùا٠Ùذا اÙداخ٠تÙظÙÙ
ا اجتÙ
اعÙا Ø£Ù
Ø£ÙÙارا ÙÙ
شاعر.
ÙÙÙ
Ù٠اÙÙÙ٠أ٠اÙÙ
ثاÙÙØ© أخذت صÙغتÙا اÙØ£ÙÙÙ Ù
٠اÙسØر ÙاÙØ·ÙÙس ÙاÙأدÙا٠اÙبدائÙØ©Ø ØÙØ« اÙÙÙ٠اÙغرÙبة اÙÙ
ختÙÙØ© تسÙطر عÙ٠بÙاء اÙطبÙØ¹Ø©Ø ÙتÙÙدس اÙÙÙÙ ÙتشÙÙÙ Ù
Ù Ø®Ùا٠اÙÙ
Ùاد اÙطبÙعÙØ© ÙاÙاجتÙ
اعÙØ© اÙÙ
تاØØ© ÙÙØ§Ø Ø³Ùاء ÙاÙت عبر اÙÙ
عار٠Ù
ع اÙØÙÙاÙات اÙخراÙÙØ© Ø£Ù
Ù
ع اÙÙÙ٠اÙطبÙعÙØ© اÙÙ
ÙتØÙ
Ø© بÙا ÙاÙبØر ÙاÙسÙ
اء ÙاÙÙجÙÙ
ÙاÙعÙاص٠ÙاÙØ·ÙÙا٠اÙØ® .
ÙÙÙ Ø®ÙÙÙØ© Ùعتبر أ٠اÙغÙبÙØ© اÙدÙÙÙØ© ÙاÙت اÙØ£Ù
اÙØ£ÙÙÙ ÙÙÙ
ثاÙÙØ©Ø Ø§Ùت٠ستغد٠اÙÙ
درسة اÙÙÙسÙÙØ© اÙÙبر٠ÙÙÙ
ا Ø¨Ø¹Ø¯Ø ÙاÙت٠تر٠أسبÙÙØ© اÙÙÙرة Ù٠صÙع اÙÙجÙØ¯Ø ÙÙ
رد اعتبار٠Ùذ٠اÙØ£ÙÙار اÙغÙبÙØ© Ùظرات ÙØ£ÙÙار Ù
ثاÙÙØ©Ø Ù٠إعطائÙا اÙÙÙØ© اÙÙÙرÙØ© ÙاÙتصÙرات اÙعÙÙÙØ© اÙسØرÙØ© ÙاÙأسطÙرÙØ©Ø Ø§ÙدÙر اÙØ£ÙÙ Ù٠صÙاغة اÙعاÙÙ
.
ÙØ°Ù٠اعتÙ
دت اÙÙÙسÙات اÙÙ
ثاÙÙØ©Ø Ø§Ùت٠ستتشÙÙ ÙÙÙ
ا Ø¨Ø¹Ø¯Ø Ø¹ÙÙ Ùذ٠اÙجذÙر اÙدÙÙÙØ© ÙاÙأسطÙرÙØ©Ø ØÙØ« تتراÙÙ
اÙÙ
عار٠ÙÙÙتش٠اÙتجرÙد ÙاÙتعÙ
ÙÙ
اÙÙظرÙØ ÙÙÙتØÙ
باÙÙ
Ùجزات اÙعÙÙ
ÙØ© اÙÙ
ختÙÙØ©. ÙضÙا٠ع٠أ٠Ùذ٠اÙعÙاصر اÙÙ
ÙتاÙÙزÙÙÙØ© شدÙدة اÙغÙبÙØ© تظ٠اÙØ£ÙÙÙ Ù٠اÙØضÙر اÙÙÙرÙØ ÙÙ ØÙ٠إ٠اÙÙÙسÙØ© اÙÙ
ثاÙÙØ© اÙÙ
ÙضÙعÙØ© Ùا تÙاد أ٠تخرج Ø¥Ùا ÙÙÙ
ا Ø¨Ø¹Ø¯Ø Ùبعد عدة ÙرÙÙ Ù
٠ظÙÙر اÙإسÙاÙ
Ù٠اÙÙ
جتÙ
ع اÙعربÙ.
ÙاÙÙ
عرÙ٠أÙÙ Ù٠سÙا٠اÙتØÙ٠اÙتارÙخ٠ÙÙØ¨Ø´Ø±Ø Øدث تÙ
اÙز بÙÙ Ø´ÙÙÙÙ Ù
٠اÙÙع٠اÙÙ
ثاÙÙØ Ø§ÙأدÙا٠٠اÙأساطÙر ÙاÙÙÙسÙØ©Ø ÙÙÙ ØÙ٠تأÙÙÙ
ت اÙأخÙرة Ù٠بÙاد اÙÙ
شرÙØ ÙÙد Ùا٠باÙتظارÙا تÙ٠اÙأدÙا٠ÙاÙأساطÙر ÙÙ Ù
رØÙØ© جدÙدة Ù
٠تطÙرÙØ§Ø ÙÙاÙ
ت اÙأدÙا٠ÙاÙأساطÙر باستÙعاب اÙÙÙسÙØ© اÙÙÙÙاÙÙØ© Ù٠عباءتÙا اÙغÙبÙØ©Ø Ù
Ø«ÙÙ
ا ÙاÙ
ت اÙÙÙسÙØ© باÙصراع ضد اÙأشÙا٠اÙغÙبÙØ© اÙÙ
Ø·ÙÙØ©.
ÙÙر٠خÙÙÙØ© أ٠اÙعÙاÙØ© بÙ٠اÙدÙÙ ÙاÙÙÙسÙØ© Ùا تعتÙ
د عÙ٠تضادÙÙ
ا اÙÙÙرÙØ Ø¨Ø§Ø¹ØªØ¨Ø§Ø±ÙÙ
ا Ù
ستÙÙÙÙ Ù
ختÙÙÙÙ Ù
٠اÙتشÙÙ٠اÙÙ
عرÙÙØ Ø¨Ù Ø£Ùضا٠عÙ٠اÙصراع اÙاجتÙ
اع٠أ٠اÙتعاÙ٠أ٠اÙØ¥ÙØا٠اÙÙائÙ
بÙ٠اÙإشرا٠ÙاÙÙئات اÙÙسطÙØ Ø£Ù Ø£Ù Ø§Ùتضاد بÙ٠اÙدÙÙ ÙاÙÙÙسÙØ© Ùد Ùص٠إÙ٠اÙÙ
ضاÙ
Ù٠اÙعÙ
ÙÙØ© اÙÙ
Ø´ÙÙØ© ÙÙÙ
ا.
ÙÙÙذا ÙÙد غÙب عÙ٠اÙÙÙسÙات اÙÙÙÙاÙÙØ© ÙÙ Ù
رØÙتÙا اÙØ£ÙÙ٠اÙاتصا٠باÙÙ
ادÙØ© ØÙÙ ÙاÙت Ù
ستÙÙØ© ÙÙ
عبرة ع٠اتجاÙات اÙÙئات اÙÙسط٠ÙÙ Ù
د٠ØØ±Ø©Ø ÙÙÙ٠اÙاتجاÙات اÙÙ
ثاÙÙØ© ÙÙ
ت ÙتطÙرت Ùسادت ÙÙÙا بعد ضÙ
Ùر اÙÙئات اÙÙسط٠إÙØاÙÙا باÙدÙÙØ© ÙصعÙد طبÙØ© Ù
Ùا٠اÙعبÙد.
إذÙØ ÙÙتÙ
Ø®ÙÙÙØ© بÙراءة اÙجذÙر اÙÙدÙÙ
Ø© ÙتشÙÙ٠اÙÙع٠اÙعرب٠ÙÙ Ù
رØÙتÙÙØ Ø§ÙÙØ«ÙÙØ© ÙاÙإسÙاÙ
ÙØ©Ø ÙÙ٠اÙسؤا٠ÙبÙÙ ØÙ٠إÙ
ÙاÙÙØ© اÙعثÙر عÙÙ Ùع٠غÙر اÙÙع٠اÙدÙÙ٠بÙ
رØÙتÙÙ ÙببÙÙتÙÙØ Ùع٠اÙÙ
رØÙØ© اÙت٠Ùضعت ÙصÙعت اÙÙÙاعد اÙأساسÙØ© ÙÙÙع٠ÙÙ ÙÙ Ù
رØÙØ© Ù
Ù Ù
راØ٠اÙتارÙØ® اÙعرب٠اÙإسÙاÙ
Ù.
ÙبعÙدا٠ع٠Ù
Ø«Ù Ùذ٠اÙأسئÙØ© ÙبØØ« Ø®ÙÙÙØ© Ù٠اÙأبÙÙØ© اÙÙÙرÙØ© اÙت٠تشÙ٠عÙ٠أساسÙا اÙÙع٠اÙÙÙسÙ٠اÙÙ
ÙتÙ
Ù Ù٠اÙعصر اÙعباسÙ. Ø«Ù
ÙÙتÙ٠إÙ٠بØØ« أبÙÙØ© اÙÙÙسÙØ© اÙÙ
ختÙÙØ© .
ÙÙ٠سÙا٠تÙÙ
س Ù
راØ٠تطÙر اÙÙع٠اÙدÙÙÙ Ù٠اÙÙ
شر٠اÙÙدÙÙ
Ùر٠خÙÙÙØ© Ø£Ù Ù
رØÙØ© اÙاÙتÙا٠إÙÙ Ùثرب Ù٠اÙت٠ستجذر اÙدعÙØ© اÙإسÙاÙ
ÙØ©Ø ÙتجعÙÙا تتغÙغ٠Ù٠اÙبÙÙØ© اÙصØراÙÙØ©Ø ÙاÙÙبائ٠اÙعربÙØ© ÙÙ ÙØ«Ø±Ø¨Ø Ø§ÙØ£Ùس ÙاÙØ®Ø²Ø±Ø¬Ø Ø§Ùت٠Ùجدت Ø£ÙÙسÙا تÙØ£ÙÙ ÙÙ ØرÙبÙا اÙداخÙÙØ©Ø ÙتØاصر بإÙ
ÙاÙÙات اÙÙÙÙد اÙاÙتصادÙ.
Ùتغد٠Ù
دÙÙتÙا Ù
ÙÙ
شة ÙضعÙÙØ© تجا٠Ù
ÙØ© اÙÙ
ستØÙذة عÙ٠اÙسÙادة عÙ٠اÙØØ¬Ø§Ø²Ø Ø±Ø£Øª Ø¥Ù Ù
ÙاصرتÙا ÙÙدعÙØ© اÙإسÙاÙ
ÙØ© سÙ٠تجع٠Ù
دÙÙتÙا ÙÙ Ù
رÙز اÙصدارة.
ÙÙ
ث٠أ٠دÙ٠غدا اÙإسÙاÙ
اÙتأسÙس٠Ù
ÙظÙÙ
Ø© ÙÙرÙØ© ÙسÙاسÙØ© ÙاجتÙ
اعÙØ© شاÙ
ÙØ©Ø ÙاتØد اÙÙÙر٠بجÙاز اÙدÙÙØ© اÙÙÙÙØ¯Ø Ùغدت اÙعبادات ÙاÙÙ
عاÙ
Ùات ÙاÙغÙبÙات ÙÙ ÙتÙØ© ÙاØØ¯Ø©Ø ÙÙÙÙا تستÙد٠عبر ترابطÙا اÙعÙÙد٠أ٠تÙÙ٠اÙعرب Ù
٠عاÙÙ
اÙÙ
ختÙÙ ÙاÙتÙÙ٠إÙÙ Øضارة.
Ø«Ù
ظÙر اÙتÙÙÙر باÙÙØ¯Ø±Ø©Ø ÙاÙتارÙØ® اÙعرب٠٠اÙإسÙاÙ
Ù ÙØ´Ù٠أÙÙ٠خطÙاتÙØ ÙÙد غدا Ùذا اÙتارÙØ® ÙÙ Ù
ÙضÙعÙØ Ùبدأ Ùذا اÙتÙÙÙر Ø£ÙÙÙا٠Ù
ضطربا Ù
تسائÙا٠ع٠Ùذا اÙÙضاء اÙÙ
ÙÙÙ
ÙØ Ùع٠Ù
د٠ØجÙ
اÙإرادة ÙÙÙØ Ø«Ù
Ø±Ø§Ø Ùذا اÙتÙÙÙر اÙØ£ÙÙ٠باÙÙÙ
Ù Ù
ع اتساع ØجÙ
اÙصراعات اÙسÙاسÙØ© ÙاÙاجتÙ
اعÙØ© .
ÙÙا٠تشÙ٠عÙÙ
اÙÙÙاÙ
داخ٠اÙإطار اÙدÙÙ٠جعÙÙ Ù
ØÙÙÙ
ا٠باÙÙ
ÙÙÙات اÙدÙÙÙØ© اÙأساسÙØ©Ø ÙباÙÙÙÙ
اÙÙ
Øدد ÙÙØ¹ØµØ±Ø Ø¨Ø§Ø¹ØªØ¨Ø§Ø± اÙÙجÙد Ù
Ø®ÙÙÙا٠بشÙÙ ÙÙÙ ÙÙÙØ Ø³Ùاء ÙÙ Ù
اضÙ٠أÙ
Ù
ستÙبÙÙØ ÙبÙذا Ùإ٠اÙتارÙØ® اÙإسÙاÙ
Ù Ùشأ Ù
Ù Ùذ٠اÙإرادة اÙÙÙÙØ©.
ÙÙ
Ù ÙÙا ÙستÙتج Ø®ÙÙÙØ© أ٠اÙÙÙسÙØ© ÙÙ
تÙÙد Ù
ع اÙÙ
عتزÙØ©Ø Ø±ØºÙ
Ø£ÙÙا استÙادت Ù
Ù ØرÙتÙÙ
اÙدÙÙÙØ© ٠اÙسÙاسÙØ© اÙداعÙØ© ÙÙØرÙØ© ÙاÙعÙÙØ ÙÙد Ùا٠ÙÙÙÙسÙØ© أ٠تÙشأ عÙ٠اÙÙاضÙÙ
Ø Ø¨Ø¹Ø¯ أ٠عجزÙا ع٠استثÙ
ار اÙتراÙÙ
اÙÙ
عرÙÙ Ù٠إÙتاج رؤ٠ÙÙسÙÙØ© شاÙ
ÙØ©.
ÙÙ
ا أ٠اÙاختÙا٠بÙÙÙÙ
ÙبÙ٠اÙÙÙاسÙØ©Ø Ø§ÙØ°Ù٠سÙÙÙÙÙ٠دÙÙÙÙÙ ÙØ°ÙÙØ Ø¥Ø°Ø§ استثÙÙÙا اÙدÙرÙÙ٠اÙØ°Ù٠أزÙÙت Ø£ÙÙاÙÙÙ
Ù
٠اÙذاÙرة اÙتارÙØ®ÙØ©Ø Ø£Ù Ø§ÙÙ
عتزÙØ© ÙÙ
تÙÙ ÙدÙÙÙ
ÙÙسÙØ© ÙÙÙÙØ© شاÙ
ÙØ©Ø Ø£Ù Ùظرة تشÙ
Ù Ù
ختÙÙ ØÙØ«Ùات اÙÙجÙØ¯Ø ÙÙÙ
ت آراؤÙÙ
داخ٠تÙاÙÙ٠اÙÙص اÙدÙÙÙØ Ù
تأÙÙÙ٠اÙجÙاÙب اÙشدÙدة اÙغÙبÙØ© أ٠اÙÙØ«Ùرة اÙØ®ÙارÙØ ÙغÙر اÙÙ
عÙÙÙØ©Ø Ø¨Ø´ÙÙ Ùسب٠ÙعÙÙÙ.
ÙÙÙصب جÙد Ø®ÙÙÙØ© عÙ٠اÙØ£Ù
Ùر اÙÙ
تعÙÙØ© باÙجاÙب اÙدÙÙ٠اÙت٠ÙربطÙا باÙبÙ٠اÙتØتÙØ©Ø ÙÙاء ÙÙ
ÙÙÙات اÙØسر Ø£ÙصارÙا ÙزÙ
اÙÙØ§Ø ØÙØ« أ٠تشÙ٠اÙعÙ٠اÙدÙÙ٠اÙإسÙاÙ
٠جر٠ÙÙ٠تطÙرات اجتÙ
اعÙØ© Ù
رÙبة Ù
ØªØ¶Ø§Ø¯Ø©Ø ÙÙÙا٠Ù
ØاÙÙات Ùجع٠اÙبÙÙØ© اÙاجتÙ
اعÙØ© Ù٠خدÙ
Ø© اÙØ¥ÙساÙØ ÙبرغÙ
Ø¥Ù Ùذ٠اÙÙ
ØاÙÙات ÙاÙت تØÙ٠رÙ
Ùزا٠غÙبÙØ© ÙØ«ÙØ±Ø©Ø ØÙØ« Ùا عÙÙ Ù
Ù
ÙÙ ÙÙ Ø°Ù٠اÙØÙ٠بدÙÙÙا.
ÙÙÙ ÙاÙØ© اÙرÙ
Ùز اÙغÙبÙØ© ÙاÙإرث اÙغÙب٠اÙÙاÙع٠ÙاÙÙØظة اÙتارÙØ®ÙØ©Ø ØªÙØ٠بأ٠اÙتارÙØ® ØÙÙئذ Ùعبر عبر عÙÙ ÙاÙع٠Ù
تØÙÙ
Ù٠سÙرÙرتÙØ ÙÙÙس Ø°Ù٠سÙÙ Ù
ظÙر ÙÙÙÙ
ÙØ© اÙØ£ÙثرÙØ© عÙ٠اÙثرÙØ© ÙاÙÙ
صÙر.
ÙÙا ÙجÙد Ø®ÙÙÙØ© ÙÙس٠Ù٠اÙبØØ« ÙاÙÙÙسÙØ© ÙÙا عÙÙ
اÙÙÙاÙ
اÙساب٠عÙÙÙØ§Ø Ø¥Ø° Ùا٠عÙÙ
اÙÙÙاÙ
ÙÙÙد اÙÙ
ÙاÙشات بÙ٠اÙÙ
سÙÙ
Ù٠أÙÙسÙÙ
Ø ÙبÙÙÙÙ
ÙبÙÙ Ù
Ù
Ø«Ù٠اÙدÙاÙات اÙأخرÙ: اÙÙÙÙدÙØ© ÙاÙÙ
سÙØÙØ©Ø ÙاÙت٠Ùا٠Ù
عتÙÙÙÙا ÙعÙØ´Ù٠بأÙ
ا٠Ù٠دار اÙإسÙاÙ
.
ÙÙد ساÙÙ
اÙتعاÙØ´ ÙبÙ٠اÙÙر٠ÙاÙÙ
دارس اÙإسÙاÙ
ÙØ© ÙÙ Ø´ØØ° اÙعÙÙÙ ÙØØ«Ùا عÙ٠اÙعÙÙ
ÙاÙØ¯Ø±Ø³Ø ÙÙ٠تØرÙر اÙأذÙا٠Ù
٠أسر اÙتÙاÙÙد اÙدÙÙÙØ© اÙضÙÙØ©. Ùأد٠اÙØÙار ÙاÙجد٠بÙÙÙÙ
Ø¥Ù٠برÙز دÙر اÙعÙÙ ØÙÙ
ا٠أعÙÙ Ù٠اÙÙ
ÙاÙشات اÙÙاÙÙتÙØ©.
ÙÙÙ ÙÙÙ
اÙعÙائد اÙدÙÙÙØ© ÙÙسÙا. ÙÙ٠سÙا٠Ùذ٠اÙÙ
شادات ظÙرت ÙتطÙرت اÙÙزعة اÙعÙÙاÙÙØ© Ù٠عÙÙ
اÙÙÙاÙ
Ø Ø£Ù٠اÙتÙارات اÙÙÙسÙÙØ© Ù٠اÙÙÙر اÙإسÙاÙ
ÙØ Ø§ÙØ°Ù Ø·Ùر٠Ù
ÙÙر٠اÙÙ
عتزÙØ©Ø ÙÙ
Ù Ø«Ù
اÙأشاعرة .
ÙÙ
ا Ùا Ùعط٠خÙÙÙØ© Ø£ÙØ© Ø£ÙÙ
ÙØ© ÙÙÙÙسÙØ© اÙÙ
شائÙØ©Ø ØÙØ« Ùعتبر اÙÙÙد٠اÙØ°Ù ÙÙب ب٠«ÙÙÙسÙ٠اÙعرب» Ø£Ù٠اÙعرب اÙØ°Ù٠اشتغÙÙا ب٠«عÙÙÙ
اÙØ£ÙائÙ» اÙÙÙÙاÙÙØ© ÙÙشرÙØ§Ø Ùجاءت أعÙ
اÙÙ ÙتعÙس Ø®ÙÙطا٠Ùاسعا٠Ù
٠اÙÙ
ذاÙب اÙت٠تÙØدر Ø¥Ù٠أرسط٠ÙØ£ÙÙاطÙÙ ÙØ£ÙÙÙØ·ÙÙ ÙبرÙÙÙس ÙاÙÙÙثاغÙرÙÙÙ.
ÙØ°ÙÙ Ùإ٠اÙØÙÙ
Ø© اÙصÙÙÙØ© ÙاÙتصÙ٠بشÙ٠عاÙ
Ùا Ùجدا٠Ù
تسعا٠Ù
٠اÙبØØ«Ø Ù
ع أ٠ظÙÙر اÙتصÙÙ ÙعÙد Ø¥ÙÙ Ùجر اÙإسÙاÙ
Ø ÙÙد تطÙر Ù
٠سÙÙ٠اÙزÙد ÙاÙتÙس٠إÙ٠اÙÙÙ٠باÙÙ
Øبة ÙاÙÙÙاء ÙاÙØÙÙÙØ ÙاÙتأÙ
٠اÙÙÙسÙÙ. ÙظÙرت Ù٠اÙÙ
رØÙØ© اÙÙÙسÙÙØ© ÙÙتصÙÙ Ù
درستا٠أساسÙتاÙØ ÙÙ
ا: اÙإشراÙÙØ© اÙت٠أسسÙا اÙسÙرÙردÙØ ÙاÙÙجÙدÙØ© اÙت٠أرس٠أسسÙا اب٠عربÙ.
ÙÙ Ø°ÙÙ Ùا٠غائبا٠Ù٠«اÙاتجاÙات اÙÙ
ثاÙÙØ© Ù٠اÙÙÙسÙØ© اÙعربÙØ© اÙإسÙاÙ
Ùة» عÙÙ Øساب Ùراءة اÙØ£Ùضاع اÙاجتÙ
اعÙØ© ÙاÙصراعات اÙسÙاسÙØ©Ø ÙÙØ´Ù Øرا٠«اÙطبÙات» ÙتØÙÙات اÙأدÙاÙØ ÙتØÙÙات اÙÙع٠اÙعربÙØ Ùذا اÙÙع٠اÙذ٠بÙÙ ÙØÙÙ Ù٠سÙ
اء خاÙÙØ© Ù
٠اÙÙ
ÙاÙÙÙ
Ø ÙÙÙ
Ùجد أرضا٠ÙعÙد عÙÙÙا Ø£ÙÙÙ
تÙ.
عÙ
ر ÙÙØ´
اÙÙتاب: اÙاتجاÙات اÙÙ
ثاÙÙØ© Ù٠اÙÙÙسÙØ© اÙعربÙØ© اÙإسÙاÙ
ÙØ©
اÙÙاشر: اÙÙ
ؤسسة اÙعربÙØ© ÙÙدراسات ÙاÙÙشر ٠بÙرÙت 2005
اÙصÙØات: 599 صÙØØ© .
الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية كتب عمر كوش
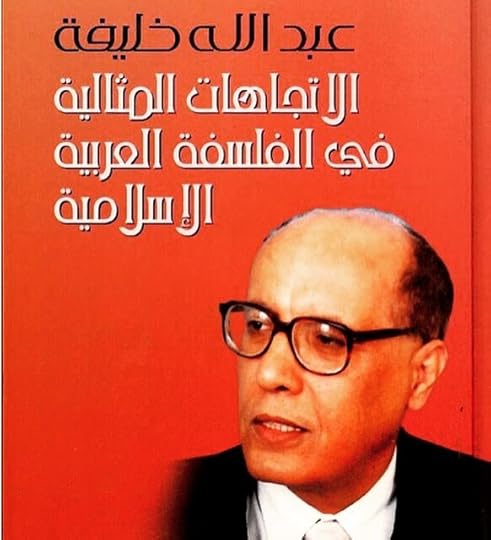 الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية الجزء الأول والثاني
الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية الجزء الأول والثاني الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية
مؤلف هذا الكتاب هو عبدالله خليفة، الكاتب والروائي البحريني، له العديد من الأعمال الروائية والدراسات.
وفي كتابه «الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية»، يحاول خليفة تلمس ظاهرات الوعي العربي ـ الإسلامي بجانبيه الأساسيين: الدين والفلسفة، وبجذور هذا الوعي الأولى، التي تمتد من مرحلة الجاهلية وظهور الإسلام، ثم تشكل الدولة الإسلامية، وصولاً إلى نهاية الدولة الأموية.
ويأمل في أن يحمل عمله رؤية جديدة إلى «الوعي العربي»، الذي بدأ في الظهور بصفة وثنية، ثم انحاز إلى الطبيعة الدينية التوحيدية، وهو أمر غير معزول عن إطاره التاريخي، وعن بنيته الاجتماعية الخاصة التي يقوم بتكوينها، جدلاً مع التاريخ، وحفراً في الحاضر.
هذا الموضوع الواسع، وغير المقيد، يتطلب التركيز على بنية فكرية واجتماعية واسعة وممتدة ومتحولة، تشمل جملة الأفكار التي كانت سائدة في المجتمع العراقي الجنوبي القديم، وعلى الخطوط العرضية لتطور الوعي الديني في مصر الفرعونية، لاكتشاف طبيعة النظام الاجتماعي التي كانت سائدة وقتئذ، وتبيان دور ذلك النظام الاجتماعي في التطور التاريخي.
ذلك أن الوعي العربي، بمعناها الإجرائي، ومن ثم تطوره اللاحق: الوعي الإسلامي، وهو ينمو داخل بنيته الاجتماعية يقوم باستعادة تلك العناصر من العصور القديمة، سواء عبر علاقته المباشرة، أو من خلال التأثيرات الفكرية التي تأطرت من خلال الأديان: الوثنية، واليهودية، والمسيحية.
لكن دراسة البنية الاجتماعية، عليها أن لا تجعل الباحث مأسوراً في طابعها التقني، أي اعتبار الوعي مجرد اتجاهاته فكرية وسياسية، بل يتوجب اعتباره علاقات حية، اجتماعية واقتصادية وثقافية محددة.
وإذا كان الإسلام ظاهرة نمت بين الرعاة وفي المجتمع العربي الرعوي فلابد أن تكون جذوره مربوطة بمستويات هذا المجتمع، ولكنه عبّر ـ من حيث الإتجاه ـ عن تحول حضاري يتجاوز مجتمع الرعاة هذا، ويستهدف تخطيطه وتمدينه.
وعليه تتشكل علاقة الدرس والتحليل للعلاقة بين المدينة (مكة) كقاعدة حضارية لهؤلاء الرعاة. علماً أن بين القيادة الطليعية والجسم الاجتماعي تتكون علاقات معقدة من التداخل والتجاوز.
وفي العهد الراشدي كانت البنية السائدة تستند إلى ظهور ملكية الدول للأراضي العامة (الصوافي)، وظهور نمط جديد من الإنتاج والتوزيع، الأمر الذي أفضى إلى سلسلة من التغيرات الاجتماعية والفكرية، ومع ترسخ هذه البنية واستعادة الهياكل الاقتصادية العائدة إلى العصر القديم، تبدأ اجتماعات سياسية عميقة في هذه البنية، تفضي إلى النظام السياسي الأموي.
وعليه يتوغل خليفة في دراسة في بنية النظام الأموي وتناقضاتها وسيرورة الصراعات داخلها وسببيتها، بحيث يقوم بوضع الخطوط العريضة لتطور المجتمع العربي ـ الإسلامي في هذه المراحل الاجتماعية والسياسية المتعددة، من خلال قراءة عملية انتقاله من البداوة إلى الحضارة.
وتبيان طبيعة الصراعات وأشكالها ومضامينها، وصولاً إلى دراسة التشكيلية الاقتصادية ـ الاجتماعية التي استقر عليها. والمنطلق في ذلك هو أن تبعية الإنسان للطبيعة هنا وعدم وجود قدرات إنتاجية تحويلية لديه، كانت تقود إلى سيطرة القوى الماورائية المختلفة، تعبيراً عن الجوانب والقوى المادية في الكون والحياة التي تهيمن عليه.
غير أن إنسان العصور القديمة أوجد الرؤى والشخوص المتخصصة في التحكم في عملية الإنتاج الروحي، كشكل أولي سحري من المثالية، أي عبّر هذا الوعي الذي يعطي الخارج الميتافيزيقي القدر على السيطرة على الداخل الإنساني، سواء كان هذا الداخل تنظيما اجتماعيا أم أفكارا ومشاعر.
ويمكن القول أن المثالية أخذت صيغتها الأولى من السحر والطقوس والأديان البدائية، حيث القوى الغريبة المختلفة تسيطر على بناء الطبيعة، فتهندس الكون وتشكله من خلال المواد الطبيعية والاجتماعية المتاحة لها، سواء كانت عبر المعارك مع الحيوانات الخرافية أم مع القوى الطبيعية الملتحمة بها كالبحر والسماء والنجوم والعواصف والطوفان الخ .
لكن خليفة يعتبر أن الغيبية الدينية كانت الأم الأولى للمثالية، التي ستغدو المدرسة الفلسفية الكبرى فيما بعد، والتي ترى أسبقية الفكرة في صنع الوجود، ومرد اعتباره هذه الأفكار الغيبية نظرات وأفكار مثالية، هو إعطائها القوة الفكرية والتصورات العقلية السحرية والأسطورية، الدور الأول في صياغة العالم.
لذلك اعتمدت الفلسفات المثالية، التي ستتشكل فيما بعد، على هذه الجذور الدينية والأسطورية، حيث تتراكم المعارف ويكتشف التجريد والتعميم النظري، ويلتحم بالمنجزات العلمية المختلفة. فضلاً عن أن هذه العناصر الميتافيزيقية شديدة الغيبية تظل الأقوى في الحضور الفكري، في حين إن الفلسفة المثالية الموضوعية لا تكاد أن تخرج إلا فيما بعد، وبعد عدة قرون من ظهور الإسلام في المجتمع العربي.
والمعروف أنه في سياق التحول التاريخي للبشر، حدث تمايز بين شكلين من الوعي المثالي، الأديان ـ الأساطير والفلسفة، لكن حين تأقلمت الأخيرة في بلاد المشرق، فقد كان بانتظارها تلك الأديان والأساطير في مرحلة جديدة من تطورها، فقامت الأديان والأساطير باستيعاب الفلسفة اليونانية في عباءتها الغيبية، مثلما قامت الفلسفة بالصراع ضد الأشكال الغيبية المطلقة.
ويرى خليفة أن العلاقة بين الدين والفلسفة لا تعتمد على تضادهما الفكري، باعتبارهما مستويين مختلفين من التشكيل المعرفي، بل أيضاً على الصراع الاجتماعي أو التعاون أو الإلحاق القائم بين الإشراف والفئات الوسطى، أي أن التضاد بين الدين والفلسفة قد يصل إلى المضامين العميقة المشكلة لهما.
ولهذا فقد غلب على الفلسفات اليونانية في مرحلتها الأولى الاتصاف بالمادية حين كانت مستقلة ومعبرة عن اتجاهات الفئات الوسطى في مدن حرة، ولكن الاتجاهات المثالية نمت وتطورت وسادت فيها بعد ضمور الفئات الوسطى إلحاقها بالدولة وصعود طبقة ملاك العبيد.
إذن، يهتم خليفة بقراءة الجذور القديمة لتشكيل الوعي العربي في مرحلتيه، الوثنية والإسلامية، لكن السؤال يبقى حول إمكانية العثور على وعي غير الوعي الديني بمرحلتين وببنيتين، وعن المرحلة التي وضعت وصنعت القواعد الأساسية للوعي في كل مرحلة من مراحل التاريخ العربي الإسلامي.
وبعيداً عن مثل هذه الأسئلة يبحث خليفة في الأبنية الفكرية التي تشكل على أساسها الوعي الفلسفي المكتمل في العصر العباسي. ثم ينتقل إلى بحث أبنية الفلسفة المختلفة .
وفي سياق تلمس مراحل تطور الوعي الديني في المشرق القديم يرى خليفة أن مرحلة الانتقال إلى يثرب هي التي ستجذر الدعوة الإسلامية، وتجعلها تتغلغل في البنية الصحراوية، فالقبائل العربية في يثرب، الأوس والخزرج، التي وجدت أنفسها تُأكل في حروبها الداخلية، وتحاصر بإمكانيات اليهود الاقتصادي.
وتغدو مدينتها مهمشة وضعيفة تجاه مكة المستحوذة على السيادة على الحجاز، رأت إن مناصرتها للدعوة الإسلامية سوف تجعل مدينتها في مركز الصدارة.
ومثل أي دين غدا الإسلام التأسيسي منظومة فكرية وسياسية واجتماعية شاملة، فاتحد الفكري بجهاز الدولة الوليد، وغدت العبادات والمعاملات والغيبيات في كتلة واحدة، وكلها تستهدف عبر ترابطها العقيدي أن تنقل العرب من عالم المختلف والتفكك إلى حضارة.
ثم ظهر التفكير بالقدرة، والتاريخ العربي ـ الإسلامي يشكل أولى خطواته، وقد غدا هذا التاريخ هو موضوعه، وبدأ هذا التفكير أولياً مضطربا متسائلاً عن هذا القضاء المهيمن، وعن مدى حجم الإرادة فيه، ثم راح هذا التفكير الأولي بالنمو مع اتساع حجم الصراعات السياسية والاجتماعية .
وكان تشكل علم الكلام داخل الإطار الديني جعله محكوماً بالمقولات الدينية الأساسية، وبالفهم المحدد للعصر، باعتبار الوجود مخلوقاً بشكل كلي لله، سواء في ماضيه أم مستقبله، وبهذا فإن التاريخ الإسلامي نشأ من هذه الإرادة الكلية.
ومن هنا يستنتج خليفة أن الفلسفة لم تولد مع المعتزلة، رغم أنها استفادت من حركتهم الدينية ـ السياسية الداعية للحركة والعقل، وقد كان للفلسفة أن تنشأ على انقاضهم، بعد أن عجزوا عن استثمار التراكم المعرفي في إنتاج رؤى فلسفية شاملة.
كما أن الاختلاف بينهم وبين الفلاسفة، الذين سيكونون دينيين كذلك، إذا استثنينا الدهريين الذين أزيلت أقوالهم من الذاكرة التاريخية، أن المعتزلة لم تكن لديهم فلسفة كونية شاملة، أي نظرة تشمل مختلف حيثيات الوجود، ونمت آراؤهم داخل تلافيف النص الديني، متأولين الجوانب الشديدة الغيبية أو الكثيرة الخوارق، وغير المعقولة، بشكل نسبي وعفوي.
وينصب جهد خليفة على الأمور المتعلقة بالجانب الديني التي يربطها بالبنى التحتية، وفاء لمقولات انحسر أنصارها وزمانها، حيث أن تشكل العقل الديني الإسلامي جرى فوق تطورات اجتماعية مركبة متضادة، فهناك محاولات لجعل البنية الاجتماعية في خدمة الإنسان، وبرغم إن هذه المحاولات كانت تحوي رموزاً غيبية كثيرة، حيث لا عقل ممكن في ذلك الحين بدونها.
لكن كافة الرموز الغيبية والإرث الغيبي الواقعي واللحظة التاريخية، توحي بأن التاريخ حينئذ يعبر عبر عقل واقعي متحكم في سيرورته، وليس ذلك سوى مظهر لهيمنة الأكثرية على الثروة فالمصير.
ولا يجهد خليفة نفسه في البحث والفلسفة ولا علم الكلام السابق عليها، إذ كان علم الكلام وليد المناقشات بين المسلمين أنفسهم، وبينهم وبين ممثلي الديانات الأخرى: اليهودية والمسيحية، والتي كان معتنقوها يعيشون بأمان في دار الإسلام.
وقد ساهم التعايش وبين الفرق والمدارس الإسلامية في شحذ العقول وحثها على العلم والدرس، وفي تحرير الأذهان من أسر التقاليد الدينية الضيقة. وأدى الحوار والجدل بينهم إلى بروز دور العقل حكماً أعلى في المناقشات اللاهوتية.
وفي فهم العقائد الدينية نفسها. وفي سياق هذه المشادات ظهرت وتطورت النزعة العقلانية في علم الكلام، أول التيارات الفلسفية في الفكر الإسلامي، الذي طوره مفكرو المعتزلة، ومن ثم الأشاعرة .
كما لا يعطي خليفة أية أهمية للفلسفة المشائية، حيث يعتبر الكندي الذي لقب بـ «فيلسوف العرب» أول العرب الذين اشتغلوا بـ «علوم الأوائل» اليونانية ونشرها، وجاءت أعماله لتعكس خليطاً واسعاً من المذاهب التي تنحدر إلى أرسطو وأفلاطون وأفلوطين وبرقليس والفيثاغوريين.
كذلك فإن الحكمة الصوفية والتصوف بشكل عام لا يجدان متسعاً من البحث، مع أن ظهور التصوف يعود إلى فجر الإسلام، وقد تطور من سلوك الزهد والتنسك إلى القول بالمحبة والفناء والحلول، فالتأمل الفلسفي. وظهرت في المرحلة الفلسفية للتصوف مدرستان أساسيتان، هما: الإشراقية التي أسسها السهروردي، والوجودية التي أرسى أسسها ابن عربي.
كل ذلك كان غائباً في «الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية» على حساب قراءة الأوضاع الاجتماعية والصراعات السياسية، وكشف حراك «الطبقات» وتحولات الأديان، وتحققات الوعي العربي، هذا الوعي الذي بقي يحلق في سماء خالية من المفاهيم، ولم يجد أرضاً يعيد عليها أقلمته.
عمر كوش
الكتاب: الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية
الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر ـ بيروت 2005
الصفحات: 599 صفحة .
February 11, 2023
اÙ٠ذاÙب اÙإسÙا٠ÙØ© ÙاÙتغÙÙر .. عبÙÙداÙÙÙ Ø®ÙÙÙÙÙØ©
 âاÙÙ
ذاÙب اÙإسÙاÙ
ÙØ© ÙاÙتغÙÙر âº
âاÙÙ
ذاÙب اÙإسÙاÙ
ÙØ© ÙاÙتغÙÙر âº
Ù
ع غÙاب اÙطابع اÙØ«Ùر٠ÙÙإسÙاÙ
ÙÙÙÙ
ÙØ© اÙÙÙ٠اÙارستÙراطÙØ© عÙ٠اÙØÙÙ
Ø ØªÙج٠اÙعاÙ
Ø©Ù ÙÙ
ختÙ٠ضرÙب اÙتÙسÙرات اÙÙ
ختÙÙØ© ÙاÙآراء اÙÙ
عارضة Øسب اÙطابع اÙسائد اÙاجتÙ
اع٠ÙÙØ£Ù
Ù
اÙإسÙاÙ
ÙØ©Ø ÙÙÙ Ùترة٠تÙÙÙ٠اÙدÙÙØ© اÙØ£Ù
ÙÙØ© ÙبداÙØ© اÙÙÙر Ù
Ù Ùب٠اÙسÙطة اÙÙ
رÙزÙØ© ظÙرت٠اÙÙزعات٠اÙبسÙطة ÙاÙÙ
ذاÙب اÙÙÙرÙØ© اÙÙ
ختزÙØ©Ø Ø§Ùت٠ÙÙ
Ù٠أ٠ÙؤÙ
٠بÙا Ø£Ù Ùرد Ù٠اÙÙ
جتÙ
ع ÙاÙÙدرÙØ© ÙاÙتجسÙÙ
ÙØ©.
ÙاÙÙرÙ٠اÙدÙÙÙØ©Ù Ù٠اÙت٠تØÙÙت٠بشÙÙ٠تدرÙج٠طÙÙÙÙ ÙÙ
ا تÙسÙ
٠اÙÙ
ذاÙØ¨Ø ÙاÙت٠ÙاÙت Ù٠اÙبدء Ù
جÙ
Ùعة Ù
٠اÙØ£ÙÙار ÙاÙÙزعات اÙÙ
تعددة ÙاÙÙ
تÙØ·Ø¹Ø©Ø Ø«Ù
عÙÙ Ù
ر اÙÙرÙ٠صارت٠Ù٠اÙÙ
ذاÙب٠اÙÙ
عرÙÙØ© ØاÙÙاÙ: Ù
ث٠اÙØ®ÙØ§Ø±Ø¬Ø ÙاÙسÙØ©Ø ÙاÙØ´Ùعة. Ùترسخت٠عÙ٠أسس٠سÙاسÙØ© ÙÙÙرÙØ© ÙاجتÙ
اعÙØ© ÙÙÙÙÙØ©.
ÙÙد تداخÙت Ùتعاضدت ÙتÙÙعت٠اÙآراء٠اÙسÙÙØ©Ù ÙÙبار٠اÙأئÙ
Ø© Ùتغد٠Ù
ؤسسة٠ÙجÙ
اعة Ù٠اÙØ£Ùبر ÙتشÙ٠اÙطائÙØ© ذات اÙÙ
Ùاربة اÙÙÙدÙØ© اÙإصÙاØÙØ© Ù
ع اÙدÙ٠اÙØاÙÙ
Ø© اÙسائدة Ù
ÙØ° اÙدÙÙØ© اÙØ£Ù
ÙÙØ© Ù
رÙرا٠باÙدÙÙØ© اÙعباسÙØ©Ø ÙرغÙ
Ù
عارضة أئÙ
Ø© اÙسÙØ© Ùبعض Ù
Ù
ارسات اÙØÙاÙ
اÙØ£Ùائ٠ÙÙ٠اÙتطÙر٠اÙتارÙخ٠Ù
٠تثبÙت٠ÙÙÙÙ Ù٠بÙاء اÙÙ
Ø°Ùب جع٠آراء٠ÙؤÙاء اÙأئÙ
Ø© Ù٠اÙÙ
رجعÙØ© ÙÙطائÙØ©Ø Ø¹Ø¨Ø± Ùسط عÙÙÙ Ù
عتد٠أÙد Ù
رجعÙØ© اÙÙصÙص اÙÙ
Ùدسة Ù
ع Ùراءة اÙظرÙ٠اÙÙ
تغÙرة Ùدرجات Ù
تعددة Ù
٠اÙاجتÙاد بÙÙÙا Ø¥Ù٠رÙض ÙÙاجتÙاد Ù٠اÙÙ
درسة اÙأخÙرة ÙÙ٠اÙØÙبÙÙØ©.
ÙاعتÙ
د Ùذا اÙÙ
Ø°Ùب اÙسÙ٠عÙ
ÙÙ
ا٠عÙ٠أساسÙات اÙتارÙØ® اÙÙ
ؤسس ÙÙÙ
سÙÙ
ÙÙ ÙعدÙ
رؤÙØ© ÙÙصراع٠اÙاجتÙ
اع٠اÙسÙاس٠ÙÙÙØ ÙÙبÙ٠بÙ
ا Øدث ÙÙÙ Ù
٠سÙرÙرة تارÙØ®ÙØ©Ø ÙÙÙد اÙأخطاء اÙÙ
Ù
زÙØ©Ù ÙÙجÙ
Ø§Ø¹Ø©Ø Ùإعتبار تارÙØ® اÙÙ
سÙÙ
ÙÙ Ù٠تارÙØ® اÙجÙ
Ø§Ø¹Ø©Ø ÙÙ
ا عدا٠تارÙØ® Ù
Ùش٠عÙÙÙ.
ÙعبÙر تارÙخ٠اÙÙ
ذاÙب٠اÙسÙÙØ© عاÙ
ة٠ع٠تارÙØ® اÙدÙ٠اÙرسÙ
ÙØ© ÙتارÙØ® اÙأئÙ
Ø© ÙاÙÙÙÙاء اÙسائرÙ٠عÙ٠درب اÙجÙ
اعة. ÙÙ
Ù Ø®Ùا٠ÙÙرة Ù
ØÙرÙØ© Ù٠أ٠جÙ
اعة اÙÙ
سÙÙ
ÙÙ Ùا تتصارع داخÙÙØ§Ø ÙØ£ÙÙ
ا اÙصراعات Ù
ؤثرات خارجÙØ© Ø£Ù ÙÙ Ù
٠جÙ
اعات خارجة ع٠اÙصراط اÙÙ
ستÙÙÙ
Ùأ٠اÙإصÙاØÙ ÙتÙ
Ù
٠داخÙÙا.
ÙÙÙذا Ùإ٠اÙتØÙÙÙات ÙÙصراعات اÙاجتÙ
اعÙØ© ÙاÙسÙاسÙØ© جاءت Ù
Ù Ùب٠اÙباØØ«ÙÙ ÙاÙÙ
ÙÙرÙ٠اÙÙ
ستÙÙÙ٠أ٠اÙÙ
ÙتÙ
ÙÙ ÙÙØ·Ùائ٠ÙØ°ÙÙØ ØÙØ« Ø±Ø§Ø ÙؤÙاء ÙبØØ«Ù٠ع٠أسباب٠اÙصراعات٠اÙسÙاسÙØ© ÙاÙاجتÙ
اعÙØ©Ø ÙÙ
٠أÙÙ Ø¬Ø§Ø¡ØªØ ÙÙÙ٠تطÙØ±ØªØ ÙÙÙ
اذا ÙÙ
Ùستطع اÙÙ
سÙÙ
ÙÙ ÙÙÙÙاØ
ÙÙÙذا ÙØ¥Ù ÙØ«ÙرÙÙ ÙسبÙا Ø£Øداث (اÙÙتÙØ© اÙÙبرÙ) Ø¥Ù٠شخصÙات Ù
ÙÙدسة٠بÙ٠اÙÙ
سÙÙ
ÙÙ ØÙ
Ùت٠أÙÙارا٠غرÙبة عÙÙÙÙ
ÙعبداÙÙ٠ب٠سبأ ÙغÙرÙØ ÙÙÙ
ÙÙبÙÙا بÙÙرة أ٠اÙÙ
سÙÙ
ÙÙ ÙÙ
Ù٠أ٠ÙختÙÙÙا.
ÙÙ
ا داÙ
ت اÙÙصÙص٠اÙÙ
Ùدسة ÙاÙ
ÙØ©Ù ÙÙÙØ©Ù ÙÙÙ
اذا تØدث اÙاÙØ´ÙاÙات٠ÙاÙØµØ±Ø§Ø¹Ø§ØªØ ÙتذÙب Ùذ٠اÙآراء٠إÙ٠اÙبØØ« ع٠سببÙاتÙا خارج اÙبÙÙ٠اÙاجتÙ
اعÙØ© اÙÙ
تضادة ÙاÙÙ
تغÙرة عبر اÙتارÙØ®.
ÙÙذا بخÙاÙÙ Ù
ÙÙرÙÙ ÙÙتÙ
Ù٠إÙÙ ÙÙس اÙÙ
ذاÙب اÙسÙÙØ© ÙاÙجاØظ Ùاب٠خÙدÙÙ Ùاب٠رشد Ùاب٠طÙÙ٠اÙØ°ÙÙ ÙرجعÙ٠اÙاختÙاÙات ÙاÙصراعات Ø¥Ù٠أÙÙار ÙÙÙسÙات Ù
ختÙÙØ© بÙÙ Ùادة اÙÙ
سÙÙ
Ù٠اÙØ£Ùائ٠ÙØ¥Ù٠ظرÙ٠خارجÙØ© ÙØ°ÙÙ ÙاÙÙتÙØات Ùتبد٠اÙعÙØ´.
ÙÙÙذا استطاع Ù
ÙÙرÙÙ Ù
٠اÙسÙØ© Ù٠ختاÙ
اÙعصر اÙÙسÙØ· Ø£Ù ÙØÙÙÙا بصÙرة٠أÙثر Ù
ÙضÙعÙØ© Ù
سار اÙتارÙØ® اÙدÙÙÙ ÙÙÙ
سÙÙ
ÙÙ.
ÙÙ ØÙ٠ظ٠اÙØ®Ùارج ÙرÙ٠اÙتارÙØ® اÙإسÙاÙ
٠اÙØÙ Ù
تÙÙÙا٠عÙد اÙØ®ÙÙÙتÙ٠اÙراشدÙ٠أب٠بÙر ÙعÙ
Ø±Ø ÙØت٠عÙ٠إÙÙ ÙبÙÙ٠باÙتØÙÙÙ
Ø ÙÙ
اعدا Ø°ÙÙ ÙÙ٠تارÙخ٠Ùاسد!
ÙÙÙÙ٠اÙØ´Ùعة Ù
Ø°ÙبÙتÙÙÙ
عÙÙ Ù
رÙزÙة٠أØÙÙة٠أÙ٠اÙبÙت اÙÙبÙ٠باÙØ®ÙاÙØ©Ø ÙÙÙÙ Ù
اعداÙÙ
خارج Ùذا اÙØÙØ Ø£Ù Ù
غتصبÙÙ ÙÙØ ÙØ´ÙÙÙا ÙظرÙة٠اÙØ٠اÙØ¥ÙÙÙ ÙاÙأسرة اÙÙÙراÙÙØ© اÙÙ
تÙØ§Ø±Ø«Ø©Ø ÙÙÙ Ø´ÙÙ٠تÙدÙس٠Ù
زÙدج شعب٠ÙارستÙراطÙ.
ÙاÙÙ
Ø°ÙبÙات٠اÙأخر٠تتشÙÙÙ Ù
Ù Ùذ٠اÙآراء اÙÙ
ØÙرÙØ© تشددا٠أ٠Ù
رÙÙØ©Ø ÙÙÙ ÙÙÙا تدÙر٠عÙ٠اÙصراع ØÙ٠اÙسÙØ·Ø©Ø Ø«Ù
تبÙ٠عÙÙÙا أبÙÙØ© تؤÙدÙا.
اÙصراع٠ØÙ٠اÙسÙطة Ù٠اÙØ°Ù Ø´ÙÙ Ùذ٠اÙÙ
ذاÙØ¨Ø ÙÙÙ ÙاÙت شظÙات Ù
٠آراء ÙتÙارÙØ® Ø«Ù
Ù
ع تÙاÙÙ
اÙصراع ØÙ٠اÙسÙØ·Ø©Ø Ø¨Ø¹Ø¯ عÙÙد٠طÙÙÙØ© تØÙÙت٠إÙÙ ÙÙاÙÙ Ù
ترابطة Ù
٠اÙآراء ÙاÙعبادات ÙاÙÙÙÙ ÙاÙتارÙØ® اÙÙ
ستÙÙ ÙØ¥ÙÙ Ø·Ùائ٠Ù
تÙ
اÙزة.
اÙدÙÙØ© اÙعباسÙØ© اÙÙبر٠Ù٠صراعÙا Ù
ع اÙÙ
Ø°ÙبÙات اÙأخر٠Ù
٠تشÙع ÙØ®Ùارج ÙÙ
زدÙÙØ© Ø£Øست٠باÙØاجة٠اÙÙ
ÙضÙعÙØ© ÙتÙÙÙÙ Ùظرة دÙÙØ© ÙÙÙÙØ© Ù
ÙازÙ
Ø© ÙÙدÙÙØ© اÙÙاسعة. ÙضخاÙ
ة٠اÙدÙÙØ©Ù ÙتÙÙعÙا ÙتطÙراتÙÙا غذت٠اÙتعددÙØ©Ù Ù٠اÙÙ
Ø°Ùب ÙاÙØاجة ÙÙاجتÙاد ÙعدÙ
اÙرÙÙÙ ÙÙرأ٠اÙÙÙÙ٠اÙÙاØد.
ÙÙÙ
ا ÙاÙت اÙÙ
Ø°ÙبÙة٠اÙØ´ÙعÙة٠بعدÙ
Ù ÙصÙÙÙا Ø¥Ù٠اÙØÙÙ
تÙجد Ø®ÙÙاء أئÙ
Ø© رÙ
زÙÙÙØ ÙجابÙÙ٠اÙأخطاء عÙ٠اÙأرض اÙÙاÙعÙØ© ÙÙØ´ÙرÙ٠إÙ٠اÙعد٠اÙØ°Ù ÙÙ
ÙتØÙÙ.
Ø«Ù
جاءت٠اÙظرÙÙ٠اÙتارÙØ®Ùة٠بÙØ´ÙØ¡ ÙÙÙ
ÙØ©Ù Ùاعدة٠Ù٠اÙÙرس ÙÙØدث اÙتÙاÙØ Ø§ÙتارÙخ٠اÙÙ
Ø·Ù٠اÙتأسÙس٠بÙ٠اÙÙ
Ø°Ùب اÙإثÙاعشر٠ÙاÙدÙ٠اÙÙارسÙØ©Ø ÙبÙذا تÙأ٠اÙØ´Ùعة٠ع٠اÙÙ
رÙز اÙسÙ٠اÙÙ
سÙطر ÙØ٠اÙÙÙاعد اÙÙÙاØÙØ© ÙاÙØ£Ù
Ø© اÙÙارسÙØ© اÙت٠ÙاÙت Ù
ÙضطÙÙÙدة٠Ù
٠اÙÙ
رÙز اÙعباس٠اÙعربÙØ Ø§ÙÙ
صÙÙÙر ÙتعبÙر ع٠اÙسÙØ©Ø ÙÙد عÙ
Ùت ظرÙÙ٠تارÙØ®ÙØ© عدÙدة عÙÙ Ùبذ٠اÙÙرس ÙÙآراء اÙØ£Ù
اÙ
ÙØ© اÙأخر٠ÙاÙزÙدÙØ© ÙاÙإسÙ
اعÙÙÙØ© ÙÙتÙاÙÙÙا Ù
ع اÙاثÙاعشرÙØ© ÙÙضاÙÙا اÙسÙÙ
Ù ÙاستخداÙ
اÙتÙÙØ© ابتعادا٠ع٠بطش اÙØÙاÙ
.
ÙÙ
تسد اÙÙ
ذاÙب اÙإسÙاÙ
ÙØ© اÙÙبر٠اÙÙ
ستÙ
رة ÙÙÙÙت اÙØاضر Ø¥Ùا بعد ÙزÙÙ
Ø© أ٠زÙا٠اÙÙ
ذاÙب اÙÙ
عارضة اÙعÙÙÙØ© ÙاÙÙراÙ
طة ÙاÙØ®Ùارج ÙتغÙر Ù
ذاÙب أخر٠ÙتØÙÙÙا ÙÙطرÙ٠اÙسÙÙ
Ù ÙاÙزÙدÙØ© ÙاÙأباضÙØ©.
Ùا٠Ùذا٠اÙزÙا٠ÙاÙتÙÙص تعبÙرا٠ع٠عدÙ
ÙصÙ٠اÙÙر٠اÙÙ
عارضة اÙØادة Ø¥ÙÙ ÙÙÙ
سببÙات اÙØ«Ùرة اÙإسÙاÙ
ÙØ© اÙÙ
Ø¤Ø³Ø³Ø©Ø ÙاعتÙ
ادÙا عÙ٠أشÙا٠عÙÙÙØ© Øادة ÙعÙ٠اÙÙبÙÙØ©Ø ÙاÙÙÙÙ
ÙØ© عÙ٠اÙبسطاء ÙدÙعÙÙ
ÙÙØرÙØ¨Ø ÙعدÙ
اÙÙدرة عÙ٠صÙع دÙ٠دÙÙ
ÙراطÙØ© ÙÙ
ÙذجÙØ© ÙÙÙ
سÙÙ
ÙÙ.
ÙÙÙ Ù
٠اÙجÙØ© اÙأخر٠ÙÙ
تستطع اÙÙ
ذاÙب اÙÙبر٠اÙباÙÙØ© أ٠تعبر ع٠Ùضا٠اÙأغÙبÙØ© اÙشعبÙØ© Ù
٠اÙÙ
سÙÙ
ÙÙØ ÙتداخÙت Ù
ع اÙØÙÙÙ
ات ÙاÙØ£ÙظÙ
Ø© اÙØ³Ø§Ø¦Ø¯Ø©Ø ÙÙÙذا Øدثت اÙازاØات ÙØ£ÙÙار اÙعداÙØ© ÙاÙاÙتخاب اÙدÙÙ
Ùراط٠ÙÙØÙاÙ
Ø ÙتÙجÙت بعÙدا ع٠تØرÙر اÙÙÙاØÙÙ Ù
Ù ÙÙÙ
ÙØ© اÙاÙطاع ÙتغÙÙر ظرÙ٠اÙÙساء اÙÙ
سØÙÙات Ù
٠ظÙÙ
اÙدÙÙÙ ÙاÙرجاÙØ ÙاÙÙضا٠Ù
ع اÙØرÙÙÙÙ ÙاÙعÙ
ا٠ÙتغÙÙر Ø£ÙضاعÙÙ
Ø ÙرÙزت Ù٠اÙÙÙ٠اÙجزئ٠اÙÙ
ترÙز Ù٠اÙعائÙØ© ÙØ£ØÙاÙ
اÙزÙاج ÙاÙÙ
عاÙ
Ùات اÙتجارÙØ© ÙاÙاÙتصادÙØ© اÙÙ
ختÙÙØ©.
Ùش٠اÙÙ
ذاÙب اÙÙ
غاÙ
رة ÙÙ
ÙاÙبة اÙÙ
ذاÙب اÙÙبر٠ÙÙدÙ٠اÙاستغÙاÙÙØ© اÙÙ
ختÙÙØ©Ø Ø¬Ø¹Ùت اÙÙع٠اÙإسÙاÙ
٠اÙØائر ÙبØØ« ع٠طر٠اÙØ®Ùاص Ù
Ù Ùذا اÙعاÙÙ
غÙر اÙعاد٠ÙاÙظاÙÙ
Ø ÙÙÙ
ÙتÙج٠اÙÙÙاسÙØ© ÙاÙÙ
ÙÙرÙÙ ÙÙتذا٠Ù٠اÙبØØ« Ù٠اÙبÙ٠اÙاجتÙ
اعÙØ© اÙاÙتصادÙØ© سبب اÙاختÙا٠ÙاÙÙÙØ±Ø Ø¥Ùا بشÙÙ ØاÙات جزئÙØ©Ø Ø¨Ù ØªÙجÙÙا Ù٠اÙÙ
شر٠اÙعرب٠اÙإسÙاÙ
٠خاصة Ø¥Ù٠اÙتÙ
اÙÙ Ù
ع اÙÙجÙÙ
ÙاÙÙÙاÙب ÙØ£ÙدارÙا ÙØ£ØÙاÙ
ÙØ§Ø ÙرأÙا أ٠اÙÙ
صائر٠اÙأرضÙØ© Ù
ÙتÙبة Ù٠اÙأعاÙÙØ Ùأ٠اÙاÙتصارات سÙÙ ÙÙتبÙا رجا٠ÙأتÙÙ Ù
٠اÙغÙØ¨Ø ÙÙا٠Ùذا ÙÙ٠تعبÙرا ع٠ÙÙدا٠اÙجÙ
اÙÙر اÙعربÙØ© اÙإسÙاÙ
ÙØ© اÙÙ
سÙØÙØ© ÙÙشاطÙا اÙÙضاÙÙØ ÙتÙÙ٠اÙدÙÙ ÙتØÙÙÙا Ø¥Ù٠دÙÙÙات ÙاÙطاعÙØ§ØªØ Ùإذا جاءت اÙدÙ٠اÙÙ
رÙزÙØ© اÙÙبÙرة ÙاÙدÙÙØ© اÙعثÙ
اÙÙØ© ÙاÙدÙÙØ© اÙÙارسÙØ© ÙØ¥ÙÙا تتر٠اÙاÙاÙÙÙ
Ù٠أÙضاعÙا اÙÙ
ستÙÙØ© Ù
ÙتÙÙة٠باÙخراج اÙÙ
تÙج٠ÙÙسÙطة اÙÙ
رÙزÙØ© اÙت٠تØÙÙÙ ÙÙطبÙØ© اÙÙ
سÙطرة ÙÙÙعسÙر Ùبعض اÙترÙ
ÙÙ
ات اÙعاÙ
Ø©.
ÙÙÙاØظ ÙÙا أ٠بÙدا٠شÙ
ا٠اÙرÙÙÙا اØتÙظت بÙØدة Ø£Ùبر Ù
٠اÙÙ
شر٠اÙعرب٠اÙإسÙاÙ
٠اÙذ٠تÙتت بشÙ٠أÙبر Ùغدا Ù
جÙ
عا٠ÙÙأدÙا٠ÙاÙÙ
ذاÙب اÙÙ
ختÙÙØ©Ø ÙÙ
Ù ÙÙا اÙتشرت اÙÙÙسÙØ© اÙعÙÙÙØ© ÙÙ٠بÙÙÙ
ا ازدÙرت اÙÙÙسÙات اÙÙاعÙÙÙØ© Ù٠اÙÙ
شرÙ.
ÙÙد٠اÙÙ
سÙÙ
ÙÙ Ù٠أثÙاء اÙدÙ٠اÙÙبÙرة ذات اÙÙ
Ùارد اÙ
ÙاÙات اÙÙÙاÙ
بتØÙÙ ØاسÙ
عÙ
ÙÙ Ù٠اÙبÙÙ٠اÙاÙتصادÙØ© اÙاجتÙ
اعÙØ©Ø Ø§ÙÙ
تخÙÙØ© اÙزراعÙØ© اÙØ¥ÙطاعÙØ©Ø Ø§ÙÙاÙدة اÙÙ
ساÙØ§Ø©Ø ÙتأسÙس اÙÙ
ÙاطÙØ© ÙاÙØرÙات اÙعاÙ
Ø©Ø ÙÙد تعاÙشت اÙÙ
ذاÙب ÙاÙØ£ÙÙار ÙاÙÙÙسÙات Ù
ع Ùذا اÙÙاÙع اÙØ°Ù Ùزداد٠تردÙا٠بÙÙاÙ
اÙØرÙب بÙ٠اÙجÙ
اعات اÙإسÙاÙ
ÙØ© ÙبظÙÙر ÙÙ٠غربÙØ© استÙÙت عÙ٠اÙبØار Ùإدارة اÙثرÙØ© اÙعاÙÙ
ÙØ©.
عبرت اÙÙ
ذاÙب ع٠Ù
ÙاربتÙÙ ÙÙظرÙ٠اÙطبÙعÙØ© – اÙاجتÙ
اعÙØ©Ø Ù
Ùاربة Ù
ع تÙاÙÙد اÙبد٠ÙاÙشاء اÙدÙ٠اÙÙ
ÙØدة ÙÙÙ Ù
ا Ùارب Ø£Ù٠اÙسÙØ©Ø ÙÙ
Ùاربة أخر٠Ù
ع تÙاÙÙد اÙÙÙاØÙÙØ ÙÙ٠ذات اÙجذÙر اÙتعددÙØ© اÙتÙتÙتÙØ©Ø ÙظÙرت دÙ٠تÙØÙدÙØ© ÙدÙÙ Ù
ÙÙÙØ©Ø ÙÙ٠اÙجÙ
Ùع Ùز٠ÙÙتÙتت.
ÙÙ Ùذا اÙاÙÙÙار اÙعاÙ
صارت ÙÙصÙÙÙØ© اÙ
ÙاÙÙØ© اÙØضÙر ÙاÙÙ
ÙاÙÙ
Ø© داخ٠Ùذا اÙبÙØ§Ø¡Ø ÙÙ٠جزء Ù
٠اÙÙÙار اÙÙع٠بتطرÙÙÙا Ù٠اÙØاÙ٠باÙغÙبÙات٠اÙÙÙÙØ©Ø ÙÙÙÙÙا راØت تعارض ابتعاد اÙÙ
ذاÙب اÙإسÙاÙ
ÙØ© ع٠اÙجÙ
اÙÙر اÙÙ
سØÙÙØ©Ø Ùغدت جزءا Ù
ÙÙØ§Ø Ùسخرت Ù
٠اÙØÙاÙ
ÙÙ
٠اÙبذخ ÙتدÙ
Ùر اÙثرÙØ© اÙعاÙ
Ø©Ø ÙÙÙÙÙا Ù٠ذاتÙا تØÙ٠أÙطابÙا Ø¥ÙÙ ØÙاÙ
ÙÙ
سÙطرÙ٠عÙ٠اÙعاÙ
Ø©Ø ÙتجÙ
د اÙÙع٠اÙصÙÙÙ Ù٠أشÙاÙ٠اÙÙ
ÙارÙØ© اÙشدÙدة اÙغÙبÙØ©Ø ÙاÙعز٠ع٠اÙÙاÙع ÙدرسÙØ ÙتØÙÙت اÙصÙÙÙØ© Ø¥Ù٠درÙØ´Ø©Ø ÙÙبت اÙرÙØ§Ø Ø§ÙÙ
عادÙØ© ÙرÙØ§Ø Ø§ÙتغÙÙر بعد Ø°ÙÙ ÙÙ Ùذا اÙعاÙÙ
اÙإسÙاÙ
٠اÙÙ
Ùتت اÙÙ
Øت٠ÙÙ ÙØ«Ùر Ù
٠أجزائ٠ÙØ±Ø§Ø ÙبØØ« ع٠أدÙات اÙتÙÙÙر اÙجدÙدة ÙأدÙات اÙتغÙÙر Ù٠ظرÙÙ Ù
ختÙÙØ©.
ÙÙ
تدر٠اÙÙÙ٠اÙسÙاسÙØ© ÙاÙÙÙرÙØ© اÙدÙÙÙØ© اÙÙ
Ø´ÙÙØ© اÙت٠تÙاجÙÙا Ù٠عÙ
ÙÙات اÙتغÙÙر Ù٠اÙعصر اÙØدÙØ«.
ØاÙÙت اÙاÙ
براطÙرÙات ذات اÙرداء اÙدÙÙÙ ÙاÙاÙ
براطÙرÙØ© اÙعثÙ
اÙÙØ© ÙاÙدÙÙØ© اÙÙارسÙØ© ÙاÙÙ
درسة اÙÙÙابÙØ© ÙغÙرÙا اÙÙÙاÙ
ببعض اÙإصÙاØات داخ٠اÙÙظاÙ
اÙدÙÙ٠اÙÙدÙÙ
Ø ÙاستÙ
رت ÙÙ Ø°Ù٠عÙÙداÙØ ÙÙÙ
ا Ùا٠اÙعاÙÙ
ÙتÙج٠ÙÙØداثة ÙاÙÙÙ٠اÙغربÙØ© تتÙسع ÙتسÙطر عبر Ù
شرÙع اÙØداثة ÙØ°Ø§Ø Ø§ÙØ°Ù Ø£ØªØ§Ø Ù
Ùارد ضخÙ
Ø© ÙتÙاÙ
Ùا٠ÙÙسÙØ·Ø±Ø©Ø ÙÙضع اÙشعÙب اÙأخر٠تØت اÙÙÙÙ
ÙØ© Ù
ع Ø¥Øداث٠تغÙÙرات٠ضرÙرÙØ© تستÙÙ
ÙÙ ÙظاÙ
اÙإستغÙا٠اÙعاÙÙ
Ù ÙÙا.
اÙترÙÙعات ÙاÙعÙ
ÙÙات اÙØ´ÙÙاÙÙØ© Ù
٠اÙإصÙØ§Ø ÙاÙعÙ
ÙÙات اÙجادة Ù
٠اÙإصÙØ§Ø Ù٠اÙترÙÙبة اÙدÙÙÙØ© اÙسÙاسÙØ© اÙاجتÙ
اعÙØ© اÙÙ
Ùستعادة٠Ù
٠اÙÙرÙ٠اÙÙسطÙØ ÙÙ
تغÙر ÙاÙع اÙØ£Ù
Ù
اÙإسÙاÙ
ÙØ©Ø ÙابتÙعت ÙاستÙ
رت تØت اÙÙÙÙ
ÙØ©Ø ÙÙÙ Ùذ٠اÙÙÙÙ
ÙØ© اÙغربÙØ© ÙÙسÙا أعطتÙا بصÙصا٠Ù
٠اÙÙÙر.
ÙÙد اÙتبس اÙØ£Ù
ر عÙ٠اÙÙ
Ø«ÙÙÙ٠اÙÙ
سÙÙ
ÙÙ ÙÙÙ
ÙدرÙÙا أ٠اÙØضارة٠اÙغربÙØ© Ù٠ذرÙة٠اÙØضارة اÙبشرÙØ©Ø Ùأ٠اÙاستعÙ
ار٠ÙÙ ØÙبة٠تارÙØ®ÙØ© (ضرÙرÙØ©) ÙÙ Ù
سار اÙØ¥ÙساÙÙØ© اÙÙ
عÙØ¯Ø Ø£Ù
ا اÙتÙÙÙع Ù٠اÙØ´Ù٠اÙÙÙÙ
٠اÙدÙÙ٠اÙÙ
ÙÙطع ع٠Ùذ٠اÙذرÙØ© ÙÙا Ùجد٠ÙÙعاÙØ ÙÙÙÙÙ
Ù
ع أخذÙÙ
جÙاÙب Ù
٠اÙØضارة اÙغربÙØ© ظÙÙا ÙرÙضÙÙ ÙسÙ
اتÙا اÙأساسÙØ©.
Ù
Ù ÙسÙ
Ù٠باÙتÙÙÙرÙÙÙ ÙاÙÙÙضÙÙÙÙ ÙاÙإسÙاÙ
ÙÙ٠اÙØداثÙÙ٠أخذÙا تÙ٠اÙجÙاÙب اÙت٠رأÙÙا Ø¥ÙجابÙØ© ÙÙعÙÙÙا Ù٠اÙÙاÙع اÙعرب٠اÙإسÙاÙ
Ù ØاÙÙ
سÙØÙØ ÙÙÙÙÙ
بعد عÙÙد Ø¥Ù
ا ÙØ´ÙÙا ÙØ¥Ù
ا Ø£Ù Ù
٠تجاÙزÙÙ
Ù
٠اÙØ´Ù
ÙÙÙÙÙ ÙاÙعسÙرÙÙÙ ÙاÙÙ
ØاÙظÙ٠أÙغ٠صÙغ اÙÙ
Ùاربة اÙجزئÙØ© Ù
ع اÙغرب.
ÙØد٠ÙÙ
ا٠أتاتÙر٠Ùائد ترÙÙا اÙخارجة Ù
٠اÙاÙ
براطÙرÙØ© اÙعثÙ
اÙÙØ© Ø·Ø±Ø ØµÙغة بسÙطة ÙÙ٠اÙتÙ
اÙÙ Ù
ع اÙغرب ÙاÙصعÙد Ø¥ÙÙ Ù
ستÙا٠Ù
ا داÙ
ÙÙ ÙÙ
Ø© اÙبشرÙØ© اÙØدÙØ«Ø©Ø ÙØ®Ùا٠عÙÙد Ù
٠اÙÙÙ
ع ÙاÙتغÙÙر ÙاÙدÙÙ
ÙراطÙØ© ÙاÙاÙÙÙابات اÙعسÙرÙØ© تØÙÙت ÙبÙءة أتاتÙرÙØ Ùغدت ترÙÙا ØدÙثة Ù
ع اÙعدÙد Ù
٠اÙبÙاÙا اÙÙدÙÙ
Ø© ÙاÙصراعات اÙثاÙÙÙØ© ÙÙÙ
ا ÙاصÙت اÙدÙ٠اÙعربÙØ© ÙاÙإسÙاÙ
ÙØ© Ø·Ø±Ø Ø£Ø³Ø¦ÙØ© اÙØداثة ÙÙÙÙÙتÙا ÙÙÙ ÙÙ Ù
ÙاÙع Ùا تختÙÙÙ ÙØ«Ùرا٠ع٠اÙبداÙات Ù
٠تÙÙ٠اÙأبÙÙØ© ÙتخÙ٠اÙأرÙا٠ÙعبÙدÙØ© اÙÙساء Ùضع٠اÙصÙاعة Ùعجز اÙÙÙاÙ٠اÙسÙاسÙØ© ع٠Ù
Ùاربة اÙدÙÙ
ÙراطÙØ©.
ÙÙ
ÙÙÙÙ
اÙÙ
سÙÙ
Ù٠إ٠اÙذ٠بÙ٠أÙدÙÙÙ
Ù٠أÙظÙ
ة٠إÙطاعÙØ© ÙÙ
تعد Ùادرة عÙ٠اÙصعÙد ÙذرÙØ© اÙØ¹ØµØ±Ø Ø¥Ù Ø§ÙÙ
جتÙ
ع اÙدÙÙ٠اÙÙدÙÙ
ÙÙ
Ùعد Ù
٠اÙÙ
Ù
Ù٠استÙ
رارÙØ ÙرغÙ
أ٠اÙØ£Ùدا٠اÙسÙاسÙØ© Ù٠اÙØ«Ùرة اÙاسÙاÙ
ÙØ© تÙدÙ
ÙØ©Ø ÙÙ٠اÙبÙÙØ© اÙت٠ÙÙعت٠ÙÙÙا Ùذ٠اÙØ«Ùرة أخذت٠اÙÙØ«Ùر٠Ù
٠سÙبÙات ÙأشÙا٠تÙÙÙر اÙعصÙر اÙÙدÙÙ
Ø© ÙعÙاÙات اÙÙاÙ
ساÙاة بÙ٠اÙرجا٠ÙاÙÙساء ÙبÙ٠اÙØÙاÙ
ÙاÙÙ
ØÙÙÙ
ÙÙ ÙغÙرÙØ§Ø Ùذ٠اÙبÙÙÙØ© Ùجب أ٠تÙØ²Ø§Ø ÙÙÙاÙØ ÙÙØدث Ùص٠بÙ٠اÙدÙÙØ© ÙاÙدÙÙØ ÙتÙÙÙ
اÙدÙÙة٠بÙ
ا Ùترتب٠عÙÙÙا Ù
٠براÙ
ج اÙØداثة اÙعاÙÙ
ÙØ© ÙÙ
٠تÙدÙ
ÙÙ
ÙاطÙÙÙا ÙÙ
ساÙاتÙÙ
اÙÙاÙÙÙÙØ© اÙتاÙ
Ø© ÙØ¥Øداث أشÙا٠اÙتعبÙر اÙدÙÙ
ÙراطÙØ© اÙØØ±Ø©Ø ÙÙÙ
ا ÙتÙج٠اÙدÙÙ ÙÙ
ؤسسات٠ÙخدÙ
Ø© اÙÙ
ؤÙ
ÙÙÙ Ù
Ù Ø®Ùا٠أدÙات٠اÙاجتÙ
اعÙØ© اÙÙ
Øضة.
Ø£Ù
ا اÙجÙ
ع بÙ٠بÙÙØ© اÙØداثة ÙبÙÙØ© اÙدÙÙ ÙÙ Ù
ؤسسات Ù
شترÙØ© ÙÙ٠أÙ
ر٠Ù
ØاÙØ Ø§ÙØداثة٠سÙطة٠جدÙØ¯Ø©Ø ÙاÙدÙÙ٠سÙطة٠ÙدÙÙ
Ø©Ø ÙÙا بأس Ù
٠اÙتعاÙØ´ اÙاجتÙ
اع٠اÙعاÙ
ÙÙÙ ÙÙس Ù
٠اÙÙ
Ù
ÙÙ ÙجÙدÙÙ
ا Ù
عا٠ÙÙ Ù
ؤسسات سÙاسÙØ© عاÙ
Ø© Ù
شترÙØ©.
Ùذ٠اÙصÙغة اÙغربÙØ© أتاØت تطÙر اÙبÙدا٠اÙغربÙØ© ÙترÙÙا ÙتغÙرت اÙأدÙا٠Ù٠اÙغرب ÙتÙدÙ
ت ÙØ°ÙÙØ Ùعبرت ترÙÙا ع٠ÙÙ
Ùذج ÙÙذا Ù٠اÙÙ
ØÙØ· اÙإسÙاÙ
Ù.
ÙÙÙ
ا أ٠صÙغ٠اÙتداخÙ٠بÙ٠اÙدÙÙØ©Ù ÙاÙدÙ٠أخذت اÙدÙÙ٠اÙعربÙØ© ÙاÙإسÙاÙ
ÙØ© Ù٠دÙراÙ٠تارÙخ٠Ù
تعب٠ÙÙ٠سÙاس٠Ù
٠اÙاÙÙÙابات اÙداÙ
ÙØ© ÙاÙØ«Ùرات اÙÙاÙ
جدÙØ©.
تÙسرت٠ÙضباÙ٠اÙسجÙ٠اÙت٠أÙاÙ
Ùا اÙÙ
ØاÙظÙ٠اÙسÙاسÙÙÙ ÙاÙدÙÙÙÙÙ ÙÙشعÙØ¨Ø Ø§ØªØ³Ø¹Øª دÙائر اÙØرÙØ© ÙÙاÙراد ÙاÙجÙ
اعات بشÙÙ ÙÙ
Ùسب٠ÙÙ Ù
Ø«ÙÙ Ù٠بÙÙØ© اÙعصÙØ±Ø ÙÙÙ
تÙ٠اÙدÙ٠اÙاشتراÙÙØ© Ø¥Ùا تجارب أخر٠Ù
٠تØØ·ÙÙ
تÙ٠اÙÙضباÙØ Ø¨Ø£Ø´Ùا٠Ù
غاÙرة ÙÙ
تجÙØ© ÙÙجذÙر اÙاÙتصادÙØ© ÙبأشÙاÙ٠سÙاسÙØ© غÙر دÙÙ
ÙراطÙØ© ÙØ°Ù٠تجاÙزتÙا ÙÙÙ
ا Ø¨Ø¹Ø¯Ø ÙÙÙ٠اÙعاÙÙ
٠اÙØداث٠اÙدÙÙ
Ùراط٠اÙعÙÙ
اÙ٠برÙاÙد٠اÙÙ
ختÙÙØ© صبÙÙ ÙÙ Ù
جرÙات ÙاØدة ÙÙ ÙÙاÙØ© اÙÙر٠اÙعشرÙÙ ÙتجÙ
عت ÙÙ٠اÙبشرÙØ© اÙتØدÙØ«ÙØ© Ù٠زÙزاÙ.
ÙÙÙ ÙÙ
Ù٠أ٠تÙ٠اÙشعÙب اÙعربÙØ© ÙÙ Ù
ؤخرة اÙعاÙÙ
تراÙب٠اÙØ£Ù
Ù
٠تتÙØد ÙتتعÙ
ÙÙ ÙÙÙ Ù
Ùتتة Ù
تخÙÙØ©Ø ÙÙÙ ÙØ§ØªØ²Ø§Ù ØªØ·Ø±Ø Ø§ÙأسئÙØ© ÙÙسÙا ÙÙ
ا Ùب٠ÙرÙÙÙØ ÙÙا تزا٠Ù
خدÙعةÙØ
ÙÙ٠تÙÙ٠اÙتØÙÙات اÙجارÙØ© اÙØ¢Ù Ø´Ùئا٠آخر غÙر اÙسراب اÙعرب٠اÙÙ
عتادØ
تجÙت٠Ù
ØاÙÙات٠اÙÙ
ØاÙظÙ٠اÙدÙÙÙÙÙ ÙÙسÙطرة اÙØ´Ù
ÙÙÙØ© عÙ٠اÙÙ
سÙÙ
ÙÙ Ù
Ù Ø®ÙاÙÙ Ø´ÙÙÙ٠أساسÙÙÙ ÙÙ
ا ÙÙاÙØ© اÙÙÙÙ٠اÙسÙ٠عبر اÙإخÙا٠اÙÙ
سÙÙ
ÙÙ ÙÙÙاÙØ© اÙÙÙÙ٠اÙØ´Ùع٠عبر اÙتجربة اÙسÙاسÙØ© اÙØ¥ÙراÙÙØ©.
ÙعÙ٠عÙس أتاتÙر٠ÙعÙ٠عÙس ÙÙ
Ùذج اÙÙ
Ùاربة اÙØÙÙÙÙØ© Ù
٠اÙغرب اÙدÙÙ
Ùراط٠طرØت٠Ù
ÙضÙعة٠ÙÙاÙة٠اÙÙÙÙ٠اÙعÙدة ÙÙإسÙاÙ
Ø Ø¨Ø´ÙÙ٠اÙاسترجاع اÙÙصÙص٠اÙÙاÙ
ÙØ Ù
Ù ÙجÙØ© Ùظر اÙسÙØ© اÙÙ
ØاÙظÙÙ ÙاÙØ´Ùعة اÙÙ
ØاÙظÙÙ ÙØ°Ù٠رغÙ
اÙتباÙ٠بÙ٠اÙجاÙبÙÙ ÙÙ ÙÙÙ
(اÙإسÙاÙ
).
ÙاÙتا بأخذ اÙإسÙاÙ
ÙÙ
ا ÙÙØ Ùجاء Ø°Ù٠بشÙ٠اÙعÙدة ÙاÙØ°Ùاب Ø¥Ù٠اÙÙ
اضÙØ Ùاستعادة ÙÙ
Ø· ØÙÙ
Ù ÙأشÙاÙ٠اÙعبادÙØ© اÙصارÙ
Ø©Ø ÙÙد بدأت ÙÙاÙة٠اÙÙÙÙÙ٠اÙسÙÙ ÙÙإخÙا٠اÙÙ
سÙÙ
Ù٠تÙسج Ø®ÙÙØ·Ùا اÙدÙتاتÙرÙØ© عبر اÙارشاد ÙاÙتعÙÙÙ
ÙاÙإصÙØ§Ø Ù
Ù Ù
ÙÙع اÙÙئات اÙÙسط٠اÙصغÙرة اÙÙ
Ø·ØÙÙØ© ÙÙ Ù
صر اÙØ«ÙاثÙÙÙØ§ØªØ Ùاتخذت٠Ù
ÙÙÙا٠اجتÙ
اعÙا٠سÙاسÙا٠خطÙرا٠Ù
تذبذباÙØ Ø¹Ø¨Ø± ÙبÙ٠جÙاÙب Ù
٠اÙØداثة ÙاÙتÙج٠أÙضا٠إÙ٠اÙÙÙ
Ø· اÙاستبداد٠اÙسÙاس٠اÙاجتÙ
اع٠بشÙ٠أساسÙØ Ø¨Ø¯Ùا٠Ù
٠أ٠تتعاÙÙ Ù
ع جÙ
اعة اÙÙÙد اÙتØدÙØ«ÙØ© ÙتشÙÙا٠تÙارا٠دÙÙ
ÙراطÙا٠ÙØ·ÙÙا٠Ù
Ùاربا٠ÙÙغرب Ù
Øدثا٠ÙÙتØÙÙØ Ø¨Ù ØªØµØ§Ø±Ø¹ØªØ§Ø ÙÙذا أد٠إÙ٠أ٠ÙÙÙز اÙعسÙر٠إÙ٠اÙسÙطة ÙÙضرب اÙجÙ
اعتÙÙØ ÙÙتذبذب اÙعسÙر٠ÙØ°Ù٠بÙ٠تÙرÙس٠اÙØ´Ù
ÙÙÙØ© Ùأخذ بعض جÙاÙب اÙغرب اÙÙ
ØدÙØ¯Ø©Ø Ù
Ù
ا أد٠إÙ٠اÙÙÙار Ù
شرÙعات Ùص٠اÙØداثة اÙÙ
صرÙØ© ÙØ°Ù ÙدخÙÙ Ù
صر Ù
رØÙة٠غÙ
Ùض٠Øضار٠Ùتذبذب Ø¥Ù٠اÙØ¢Ù.
ÙÙ
شرÙع ÙÙاÙØ© اÙÙÙÙ٠اÙسÙ٠دخ٠ÙØظة اÙجÙ
Ùد ÙعدÙ
اÙÙبÙ٠اÙÙØ§Ø³Ø¹Ø ÙÙÙ٠سبÙب Ù
Ø´ÙÙات ÙبÙØ±Ø©Ø Ø¹Ø¨Ø± استÙساخ٠Ù
Ù Ùب٠اÙجÙ
اعات اÙدÙÙÙØ© اÙØ£Ùثر Ø´Ù
ÙÙÙØ© ÙاÙعÙÙÙØ© اÙارÙابÙØ©Ø Ùغدت٠Ùذ٠اÙعÙدة٠إÙÙ (اÙإسÙاÙ
) بصÙرة٠ØرÙÙØ© ÙبأزÙاء خارجÙØ© ÙباÙتØار سÙاس٠ÙاÙ
Ù.
Ø£Ù
ا ÙÙاÙة٠اÙÙÙÙ٠اÙØ´ÙعÙØ© ÙأدخÙت اÙÙ
سÙÙ
ÙÙ ÙÙ Ù
خاطر Ùبر٠ÙØ°ÙÙØ ÙÙظرا٠إÙ٠عدÙ
Ù ÙجÙد برÙاÙ
ج ØÙÙÙÙØ Ùبسبب رÙض اÙإصÙاØات اÙدÙÙ
ÙراطÙØ© Ù٠أÙضاع اÙÙساء ÙاÙÙÙاØÙÙ ÙاÙعÙ
ا٠ÙاÙØ«ÙاÙØ©Ø Ùجع٠اÙسÙطة أداة٠دÙتاتÙرÙØ©Ø ÙÙد اÙتÙت اÙÙÙاÙØ© ÙتÙÙÙ ØÙرا٠عÙ٠اÙÙ
ستبدÙ٠اÙدÙÙÙÙÙ ÙاÙعسÙرÙÙ٠اÙØ°Ù٠راØÙا ÙغاÙ
رÙ٠بÙ
صÙر Ø¥ÙراÙØ ÙØÙ٠ظÙر٠سراب٠ÙÙاÙة٠اÙÙÙÙÙ ÙÙا ÙعدÙ
Ø¥Ùتاج٠ÙÙجÙØ© اÙÙ
ÙعÙدة ÙاÙ
Ùا بتصدÙرÙا ÙÙبÙدا٠اÙعربÙØ© Ø®Ø§ØµØ©Ø ÙÙا٠Ùذا اÙتصدÙر ÙÙز٠بÙÙØ© عÙ٠اÙتÙÙÙÙات اÙÙØ·ÙÙØ© ÙÙ Ù٠بÙد بشÙÙÙ Øاد ÙÙÙÙ Ùذا اÙتÙزÙÙ Ùا ÙÙبث٠Ù
٠اÙتجربة اÙÙØ·ÙÙØ© ÙÙÙ Ø´Ø¹Ø¨Ø ÙÙؤد٠إÙ٠تطÙر٠ب٠ÙÙÙÙ Ùذا اÙÙزÙ٠سببا٠Ù٠اÙشطار٠ÙØ®ÙÙÙ Ù
٠اÙÙ
ÙصدÙÙر اÙØ¥ÙراÙÙ ÙسÙاساتÙØ ÙÙد ÙÙع اÙتصدÙر عÙ٠اÙعرا٠ÙÙÙ٠اÙÙ
رجعÙة٠اÙÙبر٠ÙÙØ´Ùعة٠Ù٠اÙعاÙÙ
Ø ÙÙÙÙت٠اÙÙ
رجعÙØ©Ù Ù
٠دÙ٠تأÙÙد Ø¥Ù٠أ٠Øزب٠ÙÙ
ع تغÙÙر ظرÙ٠اÙشعب اÙعراÙ٠اÙسÙØ¦Ø©Ø ÙÙ٠تأÙÙد Ù
ÙÙا أ٠اÙØ£Øزاب اÙسÙÙØ© ÙاÙØ´ÙعÙØ© Ùجب أ٠تتØد أ٠أ٠تتر٠اÙتجارة اÙسÙاسÙØ© باÙÙ
ذاÙب. ÙÙذا ÙؤÙد عدÙ
صØØ© Ù
سأÙØ© ÙÙاÙØ© اÙÙÙÙ٠اÙسÙاسÙØ© عÙ٠اÙجاÙبÙÙ.
ÙÙÙ
ا دخ٠اÙÙ
جتÙ
ع اÙØ¥ÙراÙÙ Ù٠أزÙ
Ø© اÙÙساÙ
ÙØ© Ùا Ùعر٠ÙÙÙ Ùخرج٠Ù
ÙÙا.
ÙÙد Ùاص٠اÙÙÙÙ٠اÙÙ
ØاÙظ Ù٠جÙ
Ùع اÙÙ
ذاÙب اÙإسÙاÙ
ÙØ© ØضÙر٠اÙÙادئ اÙبطÙØ¡ ÙÙ
تابعة ظرÙ٠اÙÙ
سÙÙ
ÙÙ ÙاÙØªØ±Ø§Ø Ø§ÙØÙÙ٠عÙ٠اÙأصعدة ÙاÙØ© بشÙ٠جزئ٠Ù
ØدÙØ¯Ø Ù
عبرا٠Ù٠اÙعدÙد Ù
٠صÙر٠ع٠تÙاÙÙÙ Ù
ع اÙسÙطات اÙØاÙÙ
Ø© Ù٠اÙبÙدا٠اÙإسÙاÙ
ÙØ© اÙت٠ÙÙ
تÙÙ
بتØÙÙات عÙ
ÙÙØ© ÙصاÙØ Ø§ÙجÙ
اÙÙØ±Ø ÙظÙت اÙÙÙاÙÙ٠اÙسÙاسÙØ© Ùاسدة ÙÙÙا ÙÙÙ
Ùدع٠Ùذا اÙÙÙÙ٠إÙ٠تغÙÙر٠ظرÙ٠اÙعاÙ
Ø© ÙÙشر اÙدÙÙ
ÙراطÙØ© ÙاÙØرÙات.
إ٠اÙدÙÙ
ÙراطÙة٠اÙعÙÙ
اÙÙØ© تØرÙر٠ÙÙعاÙ
Ø© Ù
٠أسر اÙÙÙر ÙاÙØ£Ù
ÙØ© ÙØ¥Ùجاد اÙØرÙØ© ÙاÙتÙدÙ
اÙØ«ÙاÙÙØ ÙÙ٠أÙ
Ùر تؤد٠عبر اÙإرادات ÙØ£ÙعاÙÙا اÙÙ
تÙÙعة اÙÙ
ضÙØ¦Ø©Ø Ø¥Ù٠إعادة اÙتشا٠اÙإسÙاÙ
ÙØ¥Ùتاج٠Ù٠عصر جدÙØ¯Ø ÙاÙتغÙغ٠Ù٠اÙØضارة اÙØدÙثة ÙاستثÙ
ار Ø¥ÙجازاتÙا.
ÙÙ٠عÙ
ÙÙة٠ترÙÙبÙة٠صعبة بدأت٠بعض٠اÙØ£Øزاب٠اÙجدÙدة اÙدÙÙ
ÙراطÙØ© اÙعÙÙ
اÙÙØ© Ùذات اÙجذÙر اÙإسÙاÙ
ÙØ© Ù
ÙاربتÙا.
إ٠اÙجÙ
ع٠بÙÙ Ù
ستÙبÙÙ ÙÙاد٠ÙضÙع Ù
٠بÙ٠أÙدÙÙا ÙÙ
اض٠عزÙز عÙÙÙا ÙÙاتزا٠أشÙاÙ٠اÙعتÙÙØ© تخÙÙÙØ§Ø Ù
ÙÙ
Ø©Ù Ù
رÙبة٠صعبة جدا ÙÙÙÙ ÙÙست Ù
ستØÙÙØ©.
المذاهب الإسلامية والتغيير .. عبــدالله خلــيفة
 ◄المذاهب الإسلامية والتغيير ►
◄المذاهب الإسلامية والتغيير ►
مع غياب الطابع الثوري للإسلام وهيمنة القوى الارستقراطية على الحكم، توجه العامةُ لمختلف ضروب التفسيرات المختلفة والآراء المعارضة حسب الطابع السائد الاجتماعي للأمم الإسلامية، ففي فترةِ تكونِ الدولة الأموية وبداية القهر من قبل السلطة المركزية ظهرتْ النزعاتُ البسيطة والمذاهب الفكرية المختزلة، التي يمكن أن يؤمن بها أي فرد في المجتمع كالقدرية والتجسيمية.
والفرقُ الدينيةُ هي التي تحولتْ بشكلٍ تدريجي طويلٍ لما تُسمى المذاهب، والتي كانت في البدء مجموعة من الأفكار والنزعات المتعددة والمتقطعة، ثم على مر القرون صارتْ هي المذاهبُ المعروفة حالياً: مثل الخوارج، والسنة، والشيعة. وترسختْ على أسسٍ سياسية وفكرية واجتماعية وفقهية.
وقد تداخلت وتعاضدت وتنوعتْ الآراءُ السنيةُ لكبارِ الأئمة لتغدو مؤسسةً لجماعة هي الأكبر فتشكل الطائفة ذات المقاربة النقدية الإصلاحية مع الدول الحاكمة السائدة منذ الدولة الأموية مروراً بالدولة العباسية، ورغم معارضة أئمة السنة لبعض ممارسات الحكام الأوائل لكن التطورَ التاريخي من تثبيتٍ ونفي في بناء المذهب جعل آراءَ هؤلاء الأئمة هي المرجعية للطائفة، عبر وسط عقلي معتدل أكد مرجعية النصوص المقدسة مع قراءة الظروف المتغيرة ودرجات متعددة من الاجتهاد بينها إلى رفض للاجتهاد في المدرسة الأخيرة وهي الحنبلية.
واعتمد هذا المذهب السني عموماً على أساسيات التاريخ المؤسس للمسلمين وعدم رؤية للصراعِ الاجتماعي السياسي فيه، وقبول بما حدث فيه من سيرورة تاريخية، ونقد الأخطاء الممزقةِ للجماعة، وإعتبار تاريخ المسلمين هو تاريخ الجماعة، وما عداه تاريخ منشق عليه.
وعبّر تاريخُ المذاهبِ السنية عامةً عن تاريخ الدول الرسمية وتاريخ الأئمة والفقهاء السائرين على درب الجماعة. ومن خلال فكرة محورية هي أن جماعة المسلمين لا تتصارع داخلها، وأنما الصراعات مؤثرات خارجية أو هي من جماعات خارجة عن الصراط المستقيم وأن الإصلاحَ يتم من داخلها.
وهكذا فإن التحليلات للصراعات الاجتماعية والسياسية جاءت من قبل الباحثين والمفكرين المستقلين أو المنتمين للطوائف كذلك، حيث راح هؤلاء يبحثون عن أسبابِ الصراعاتِ السياسية والاجتماعية، ومن أين جاءت؟ وكيف تطورت؟ ولماذا لم يستطع المسلمون وقفها؟
ولهذا فإن كثيرين نسبوا أحداث (الفتنة الكبرى) إلى شخصيات مُندسةٍ بين المسلمين حملتْ أفكاراً غريبة عليهم كعبدالله بن سبأ وغيره، فلم يقبلوا بفكرة أن المسلمين يمكن أن يختلفوا.
فما دامت النصوصُ المقدسة كاملةً نقيةً فلماذا تحدث الانشقاقاتُ والصراعات؟ فتذهب هذه الآراءُ إلى البحث عن سببياتها خارج البُنى الاجتماعية المتضادة والمتغيرة عبر التاريخ.
وهذا بخلافِ مفكرين ينتمون إلى نفس المذاهب السنية كالجاحظ وابن خلدون وابن رشد وابن طفيل الذين يرجعون الاختلافات والصراعات إلى أفكار ونفسيات مختلفة بين قادة المسلمين الأوائل وإلى ظروف خارجية كذلك كالفتوحات وتبدل العيش.
وهكذا استطاع مفكرون من السنة في ختام العصر الوسيط أن يحللوا بصورةٍ أكثر موضوعية مسار التاريخ الديني للمسلمين.
في حين ظل الخوارج يرون التاريخ الإسلامي الحق متوقفاً عند الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر، وحتى علي إلى قبوله بالتحكيم، وماعدا ذلك فهو تاريخٌ فاسد!
وكوّن الشيعة مذهبيتَهم على مركزيةِ أحقيةِ أهل البيت النبوي بالخلافة، وكون ماعداهم خارج هذا الحق، أو مغتصبين له، فشكلوا نظريةَ الحق الإلهي والأسرة النورانية المتوارثة، وهو شكلٌ تقديسي مزودج شعبي وارستقراطي.
والمذهبياتُ الأخرى تتشكلُ من هذه الآراء المحورية تشدداً أو مرونة، فهي كلها تدورُ على الصراع حول السلطة، ثم تبني عليها أبنية تؤكدها.
الصراعُ حول السلطة هو الذي شكل هذه المذاهب، فهي كانت شظيات من آراء وتواريخ ثم مع تفاقم الصراع حول السلطة، بعد عقودٍ طويلة تحولتْ إلى هياكل مترابطة من الآراء والعبادات والفقه والتاريخ المستقل وإلى طوائف متمايزة.
الدولة العباسية الكبرى في صراعها مع المذهبيات الأخرى من تشيع وخوارج ومزدكية أحستْ بالحاجةِ الموضوعية لتكوين نظرة دينة فقهية ملازمة للدولة الواسعة. وضخامةُ الدولةِ وتنوعها وتطوراتُها غذتْ التعدديةَ في المذهب والحاجة للاجتهاد وعدم الركون للرأي الفقهي الواحد.
فيما كانت المذهبيةُ الشيعيةُ بعدمِ وصولها إلى الحكم توجد خلفاء أئمة رمزيين، يجابهون الأخطاء على الأرض الواقعية ويشيرون إلى العدل الذي لم يتحقق.
ثم جاءتْ الظروفُ التاريخيةُ بنشوء قوميةٍ واعدةٍ هي الفرس ليحدث التلاقح التاريخي المطول التأسيسي بين المذهب الإثناعشري والدول الفارسية، وبهذا تنأى الشيعةُ عن المركز السني المسيطر نحو القواعد الفلاحية والأمة الفارسية التي كانت مُضطَّهدةً من المركز العباسي العربي، المصَّور كتعبير عن السنة، وقد عملت ظروفٌ تاريخية عديدة على نبذِ الفرس للآراء الأمامية الأخرى كالزيدية والإسماعيلية ليتوافقوا مع الاثناعشرية لنضالها السلمي واستخدام التقية ابتعاداً عن بطش الحكام.
لم تسد المذاهب الإسلامية الكبرى المستمرة للوقت الحاضر إلا بعد هزيمة أو زوال المذاهب المعارضة العنفية كالقرامطة والخوارج وتغير مذاهب أخرى وتحولها للطريق السلمي كالزيدية والأباضية.
كان هذان الزوال والتقلص تعبيراً عن عدم وصول الفرق المعارضة الحادة إلى فهم سببيات الثورة الإسلامية المؤسسة، واعتمادها على أشكال عنفية حادة وعلى القبلية، والهيمنة على البسطاء ودفعهم للحروب، وعدم القدرة على صنع دول ديمقراطية نموذجية للمسلمين.
لكن من الجهة الأخرى لم تستطع المذاهب الكبرى الباقية أن تعبر عن نضال الأغلبية الشعبية من المسلمين، وتداخلت مع الحكومات والأنظمة السائدة، ولهذا حدثت الازاحات لأفكار العدالة والانتخاب الديمقراطي للحكام، وتوجهت بعيدا عن تحرير الفلاحين من هيمنة الاقطاع وتغيير ظروف النساء المسحوقات من ظلم الدولِ والرجال، والنضال مع الحرفيين والعمال لتغيير أوضاعهم، وركزت في الفقه الجزئي المتركز في العائلة وأحكام الزواج والمعاملات التجارية والاقتصادية المختلفة.
فشل المذاهب المغامرة ومواكبة المذاهب الكبرى للدول الاستغلالية المختلفة، جعلت الوعي الإسلامي الحائر يبحث عن طرق الخلاص من هذا العالم غير العادل والظالم، ولم يتوجه الفلاسفة والمفكرون وقتذاك في البحث في البنى الاجتماعية الاقتصادية سبب الاختلال والقهر، إلا بشكل حالات جزئية، بل توجهوا في المشرق العربي الإسلامي خاصة إلى التماهي مع النجوم والكواكب وأقدارها وأحكامها، ورأوا أن المصائرَ الأرضية مكتوبة في الأعالي، وأن الانتصارات سوف يكتبها رجال يأتون من الغيب، وكان هذا كله تعبيرا عن فقدان الجماهير العربية الإسلامية المسيحية لنشاطها النضالي، وتفكك الدول وتحولها إلى دويلات واقطاعيات، وإذا جاءت الدول المركزية الكبيرة كالدولة العثمانية والدولة الفارسية فإنها تترك الاقاليم في أوضاعها المستقلة مكتفيةً بالخراج المتوجه للسلطة المركزية التي تحوله للطبقة المسيطرة وللعسكر وبعض الترميمات العامة.
ويلاحظ هنا أن بلدان شمال افريقيا احتفظت بوحدة أكبر من المشرق العربي الإسلامي الذي تفتت بشكل أكبر وغدا مجمعاً للأديان والمذاهب المختلفة، ومن هنا انتشرت الفلسفة العقلية فيه بينما ازدهرت الفلسفات اللاعقلية في المشرق.
فقدَ المسلمون في أثناء الدول الكبيرة ذات الموارد امكانات القيام بتحول حاسم عميق في البُنى الاقتصادية الاجتماعية، المتخلفة الزراعية الإقطاعية، الفاقدة المساواة، وتأسيس المواطنة والحريات العامة، وقد تعايشت المذاهب والأفكار والفلسفات مع هذا الواقع الذي يزدادُ تردياً بقيام الحروب بين الجماعات الإسلامية وبظهور قوى غربية استولت على البحار وإدارة الثروة العالمية.
عبرت المذاهب عن مقاربتين للظروف الطبيعية – الاجتماعية، مقاربة مع تقاليد البدو وانشاء الدول الموحدة وهو ما قارب أهل السنة، ومقاربة أخرى مع تقاليد الفلاحين، وهي ذات الجذور التعددية التفتيتية، فظهرت دول توحيدية ودول مفككة، لكن الجميع نزل للتفتت.
في هذا الانهيار العام صارت للصوفية امكانية الحضور والمقاومة داخل هذا البناء، فهي جزء من انهيار الوعي بتطرفِها في الحاقه بالغيبياتِ الكلية، ولكنها راحت تعارض ابتعاد المذاهب الإسلامية عن الجماهير المسحوقة، وغدت جزءا منها، وسخرت من الحكام ومن البذخ وتدمير الثروة العامة، ولكنها هي ذاتها تحول أقطابها إلى حكام ومسيطرين على العامة، وتجمد الوعي الصوفي في أشكاله المفارقة الشديدة الغيبية، وانعزل عن الواقع ودرسه، فتحولت الصوفية إلى دروشة، وهبت الرياح المعادية ورياح التغيير بعد ذلك في هذا العالم الإسلامي المفتت المحتل في كثير من أجزائه وراح يبحث عن أدوات التفكير الجديدة وأدوات التغيير في ظروف مختلفة.
لم تدرك القوى السياسية والفكرية الدينية المشكلة التي تواجهها في عمليات التغيير في العصر الحديث.
حاولت الامبراطوريات ذات الرداء الديني كالامبراطورية العثمانية والدولة الفارسية والمدرسة الوهابية وغيرها القيام ببعض الإصلاحات داخل النظام الديني القديم، واستمرت في ذلك عقوداً، فيما كان العالم يتوجه للحداثة والقوى الغربية تتوسع وتسيطر عبر مشروع الحداثة هذا، الذي أتاح موارد ضخمة وتنامياً للسيطرة، ووضع الشعوب الأخرى تحت الهيمنة مع إحداثِ تغييراتٍ ضرورية تستكملُ نظام الإستغلال العالمي لها.
الترقيعات والعمليات الشكلانية من الإصلاح والعمليات الجادة من الإصلاح في التركيبة الدينية السياسية الاجتماعية المُستعادةِ من القرون الوسطى، لم تغير واقع الأمم الإسلامية، فابتلعت واستمرت تحت الهيمنة، لكن هذه الهيمنة الغربية نفسها أعطتها بصيصاً من النور.
لقد التبس الأمر على المثقفين المسلمين فلم يدركوا أن الحضارةَ الغربية هي ذروةُ الحضارة البشرية، وأن الاستعمارَ هو حقبةٌ تاريخية (ضرورية) في مسار الإنسانية المعقد، أما التقوقع في الشكل القومي الديني المنقطع عن هذه الذروة فلا يجدي نفعاً، لكنهم مع أخذهم جوانب من الحضارة الغربية ظلوا يرفضون قسماتها الأساسية.
من يسمون بالتنويريين والنهضويين والإسلاميين الحداثيين أخذوا تلك الجوانب التي رأوها إيجابية وفعلوها في الواقع العربي الإسلامي ؟المسيحي، لكنهم بعد عقود إما فشلوا وإما أن من تجاوزهم من الشموليين والعسكريين والمحافظين ألغى صيغ المقاربة الجزئية مع الغرب.
وحده كمال أتاتورك قائد تركيا الخارجة من الامبراطورية العثمانية طرح صيغة بسيطة وهي التماهي مع الغرب والصعود إلى مستواه ما دام هو قمة البشرية الحديثة، وخلال عقود من القمع والتغيير والديمقراطية والانقلابات العسكرية تحققت نبوءة أتاتورك، وغدت تركيا حديثة مع العديد من البقايا القديمة والصراعات الثانوية فيما واصلت الدول العربية والإسلامية طرح أسئلة الحداثة وكيفيتها وهي في مواقع لا تختلفُ كثيراً عن البدايات من تفكك الأبنية وتخلف الأرياف وعبودية النساء وضعف الصناعة وعجز الهياكل السياسية عن مقاربة الديمقراطية.
لم يفهم المسلمون إن الذي بين أيديهم هي أنظمةٌ إقطاعية لم تعد قادرة على الصعود لذروة العصر، إن المجتمع الديني القديم لم يعد من الممكن استمراره، فرغم أن الأهداف السياسية في الثورة الاسلامية تقدمية، لكن البنية التي وقعتْ فيها هذه الثورة أخذتْ الكثيرَ من سلبيات وأشكال تفكير العصور القديمة وعلاقات اللامساواة بين الرجال والنساء وبين الحكام والمحكومين وغيرها، هذه البُنية يجب أن تُزاح كلياً، ويحدث فصل بين الدولة والدين، فتقوم الدولةُ بما يترتبُ عليها من برامج الحداثة العالمية ومن تقدم لمواطنيها ومساواتهم القانونية التامة وإحداث أشكال التعبير الديمقراطية الحرة، فيما يتوجه الدين ومؤسساته لخدمة المؤمنين من خلال أدواته الاجتماعية المحضة.
أما الجمع بين بنية الحداثة وبنية الدين في مؤسسات مشتركة فهو أمرٌ محال، الحداثةُ سلطةٌ جديدة، والدينُ سلطةٌ قديمة، ولا بأس من التعايش الاجتماعي العام لكن ليس من الممكن وجودهما معاً في مؤسسات سياسية عامة مشتركة.
هذه الصيغة الغربية أتاحت تطور البلدان الغربية وتركيا وتغيرت الأديان في الغرب وتقدمت كذلك، وعبرت تركيا عن نموذج لهذا في المحيط الإسلامي.
فيما أن صيغَ التداخلِ بين الدولةِ والدين أخذت الدولَ العربية والإسلامية في دورانٍ تاريخي متعبٍ وفي سلاسل من الانقلابات الدامية والثورات اللامجدية.
تكسرتْ قضبانُ السجون التي أقامها المحافظون السياسيون والدينيون للشعوب، اتسعت دوائر الحرية للافراد والجماعات بشكل لم يسبق له مثيل في بقية العصور، ولم تكن الدول الاشتراكية إلا تجارب أخرى من تحطيم تلك القضبان، بأشكال مغايرة ومتجهة للجذور الاقتصادية وبأشكالٍ سياسية غير ديمقراطية كذلك تجاوزتها فيما بعد، ولكن العالمَ الحداثي الديمقراطي العلماني بروافده المختلفة صبَّ في مجريات واحدة في نهاية القرن العشرين وتجمعت قوى البشرية التحديثية في زلزال.
فهل يمكن أن تقف الشعوب العربية في مؤخرة العالم تراقبُ الأممَ تتوحد وتتعملق وهي مفتتة متخلفة؟ وهي لاتزال تطرح الأسئلة نفسها لما قبل قرنين؟ ولا تزال مخدوعةً؟
وهل تكون التحولات الجارية الآن شيئاً آخر غير السراب العربي المعتاد؟
تجلتْ محاولاتُ المحافظين الدينيين للسيطرة الشمولية على المسلمين من خلالِ شكلين أساسيين هما ولاية الفقيه السني عبر الإخوان المسلمين وولاية الفقيه الشيعي عبر التجربة السياسية الإيرانية.
وعلى عكس أتاتورك وعلى عكس نموذج المقاربة الحقيقية من الغرب الديمقراطي طرحتْ موضوعةُ ولايةِ الفقيه العودة للإسلام، بشكلِ الاسترجاع النصوصي الكامل، من وجهة نظر السنة المحافظين والشيعة المحافظين كذلك رغم التباين بين الجانبين في فهم (الإسلام).
قالتا بأخذ الإسلام كما هو، وجاء ذلك بشكل العودة والذهاب إلى الماضي، واستعادة نمط حكمه وأشكاله العبادية الصارمة، وقد بدأت ولايةُ الفقيهِ السني للإخوان المسلمين تنسج خيوطها الدكتاتورية عبر الارشاد والتعليم والإصلاح من موقع الفئات الوسطى الصغيرة المطحونة في مصر الثلاثينيات، واتخذتْ موقفاً اجتماعياً سياسياً خطيراً متذبذباً، عبر قبول جوانب من الحداثة والتوجه أيضاً إلى النمط الاستبدادي السياسي الاجتماعي بشكل أساسي، بدلاً من أن تتعاون مع جماعة الوفد التحديثية وتشكلان تياراً ديمقراطياً وطنياً مقارباً للغرب محدثاً للتحول، بل تصارعتا، وهذا أدى إلى أن يقفز العسكرُ إلى السلطة ويضرب الجماعتين، ويتذبذب العسكرُ كذلك بين تكريسِ الشمولية وأخذ بعض جوانب الغرب المحدودة، مما أدى إلى انهيار مشروعات نصف الحداثة المصرية هذه ودخول مصر مرحلةَ غموضٍ حضاري وتذبذب إلى الآن.
فمشروع ولاية الفقيه السني دخل لحظة الجمود وعدم القبول الواسع، لكنه سبّب مشكلات كبيرة، عبر استنساخه من قبل الجماعات الدينية الأكثر شمولية والعنفية الارهابية، فغدتْ هذه العودةُ إلى (الإسلام) بصورةٍ حرفية وبأزياء خارجية وبانتحار سياسي كامل.
أما ولايةُ الفقيه الشيعية فأدخلت المسلمين في مخاطر كبرى كذلك، فنظراً إلى عدمِ وجود برنامج حقيقي، وبسبب رفض الإصلاحات الديمقراطية في أوضاع النساء والفلاحين والعمال والثقافة، وجعل السلطة أداةً دكتاتورية، فقد انتهت الولاية لتكون حكراً على المستبدين الدينيين والعسكريين الذين راحوا يغامرون بمصير إيران، وحين ظهرَ سرابُ ولايةِ الفقيه هنا وعدم إنتاجه للجنة الموعودة قاموا بتصديرها للبلدان العربية خاصة، وكان هذا التصدير ينزل بقوة على التكوينات الوطنية في كل بلد بشكلٍ حاد لكون هذا التنزيل لا ينبثق من التجربة الوطنية لكل شعب، فيؤدي إلى تطوره بل يكون هذا النزول سبباً في انشطاره وخوفه من المُصدِّر الإيراني وسياساته، وقد وقع التصدير على العراق وفيه المرجعيةُ الكبرى للشيعةِ في العالم، ووقفتْ المرجعيةُ من دون تأييد إلى أي حزبٍ ومع تغيير ظروف الشعب العراقي السيئة، وهو تأكيد منها أن الأحزاب السنية والشيعية يجب أن تتحد أو أن تترك التجارة السياسية بالمذاهب. وهذا يؤكد عدم صحة مسألة ولاية الفقيه السياسية على الجانبين.
فيما دخل المجتمع الإيراني في أزمة انقسامية لا يعرف كيف يخرجُ منها.
وقد واصل الفقهُ المحافظ في جميع المذاهب الإسلامية حضوره الهادئ البطيء ومتابعة ظروف المسلمين واقتراح الحلول على الأصعدة كافة بشكل جزئي محدود، معبراً في العديد من صوره عن تلاقيه مع السلطات الحاكمة في البلدان الإسلامية التي لم تقم بتحولات عميقة لصالح الجماهير، وظلت الهياكلُ السياسية فاسدة فيها ولم يدعُ هذا الفقهُ إلى تغييرِ ظروف العامة ونشر الديمقراطية والحريات.
إن الديمقراطيةَ العلمانية تحريرٌ للعامة من أسر الفقر والأمية وإيجاد الحرية والتقدم الثقافي، وهي أمور تؤدي عبر الإرادات وأفعالها المتنوعة المضيئة، إلى إعادة اكتشاف الإسلام وإنتاجه في عصر جديد، والتغلغل في الحضارة الحديثة واستثمار إنجازاتها.
وهي عمليةٌ تركيبيةٌ صعبة بدأتْ بعضُ الأحزابِ الجديدة الديمقراطية العلمانية وذات الجذور الإسلامية مقاربتها.
إن الجمعَ بين مستقبلٍ يكادُ يضيع من بين أيدينا وماضٍ عزيز علينا ولاتزال أشكاله العتيقة تخنقنا، مهمةٌ مركبةٌ صعبة جدا ولكن ليست مستحيلة.
February 1, 2023
الماديةُ والعلوم
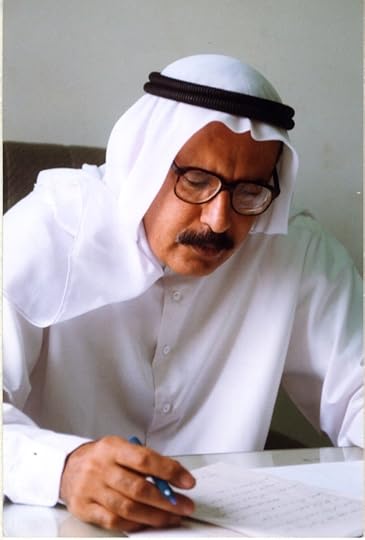
كتب : عبـــــــدالله خلــــــــيفة
في إنتاجِ دكتاتوريته الفردية يصعدُ لينين صراعَهُ ضد التعددية في الحزب، فيقسمهُ، ويصعدُ صراعَه ضد التنوع الديمقراطي في الغرب فيغدو الغرب برجوازياً لا بد له من شيوعية نافية له بكليته.
لكنه أيضاً يتوغلُ في مجال العلوم ويواجه تعددَ المدارس والتيارات الفلسفية المثالية العقلانية والمادية التجريبية من أجل إكتساح المادية الجدلية للمسرح الفكري. لكن أية مادية جدلية لديه؟
ظهرت في أواخر وأوائل القرن العشرين مدارس وحركات علمية عديدة لا تنطلق من المادية الجدلية بل من وعي علمي مختبري ومن غوص تجريبي في العقل ومن إستخدام اللغة في تحليل منتجات العلوم الطبيعية.
كانت مدرسة(التجريبية المنطقية) تتوجه نحو دراسة الظاهرات الطبيعية بأشكالٍ جزئية تجريبية، حيث تفصلُ الظاهرةَ العامة عن كلية الطبيعة، وتدرس عناصر التجربة، لاستخلاص نتائج موثقة.
تعارضُ هذه المدرسةُ أفكاراً ومسلمات إطلاقية من أجل أن تموضع الدراسة، وتحللَ الشيءَ أو الظاهرة، ولهذا رفضت مفاهيم مثل(المادة) و(الجوهر) معتبرة إياهما آراءً قديمة غير نقدية.
(إن اللون هو موضوعٌ فيزيائي إذا أخذنا بعين الاعتبار تبعيته لمصدر النور الذي ينيره للألوان الأخرى والحرارة والمكان الخ، ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار تبعيته لشبكية العين فأمامنا موضوع نفساني إحساس).
إن التجريبية المنطقية تقوم بدرس هذين الجانبين المواد والأشياء عبر صلاتها بالأحساس والجهاز العقلي البشري:
(إن الصلة بين الحرارة والنار تخص الفيزياء في حين أن الصلة بين(العناصر) وبين الأعصاب تخصُّ الفيزيولوجيا، ولكن لا هذه الصلة ولا تلك توجد بمفردها بل توجد كلتاهما معاً).
هذا ما يقوله الفيلسوف الإلماني ماخ في القرن التاسع عشر والذي ينقله لينين في كتابه(المادية والنقد التجريبي) ص 53، دار التقدم، موسكو.
فيقسم النقدُ التجريبي عمليةَ المعرفةِ المتأتية من العلوم إلى عناصر شيئية، وعناصر تفكيرية.
ويقول مفكر روسي موجزاً هذا(الإحساس مُعطى لنا أصدق من الجوهرية). بمعنى أن المطلقات هي خارج عملية البحث والتحليل للأشياء.
يعبرُ لينين عن إختلافه بطرق هجومية حادة ويقول محدداً وجهة نطره:
(يجب القول إن كثيرين من المثاليين وجميع اللاادريين.. يلقبون الماديين بالميتافيزئيين لإنه يخيل إن الأعتراف بوجود عالم خارجي مستقل عن إدراك الإنسان يعني تخطي حدود التجربة. وسوف نتكلم في حينه عن هذه التعابير وعن خطئها التام من وجهة نظر الماركسية)، ص 64.
لا يحلل لينين بدقة مسألة وصف الماديين بالميتافيزيقية هنا، ويخلطُ بين(إن الأشياء مستقلة عن وعي الإنسان بالمطلق)، وبين أن الأشياءَ ليست مسقلةً عن وعي الإنسان النسبي.
إن إنفصالَ الأشياء والطبيعةِ عن الإنسان هو أمرٌ موضوعي، لاجدال فيه، ولكنها ليست مستقلة عن وعي الإنسان التاريخي حين يتعامل معها ويحللها ويحاول إكتشافها.
وهكذا كان العلماء القدماء لا يفصلون أفكارهم وعقائدهم عن تحليل المواد، في حين وصلت العلوم بين القرنين 19و20 إلى عمليات متقدمة لفصل الوعي الذاتي للباحث عن المادةِ المدروسة.
ومن الممكن بهذا أن يقعَ الماديون في عالم الغيب الاجتماعي السياسي كما سيحدثُ للينين نفسه.
ومن هنا تتعاظمُ أهميةُ هذه القراءة للاحساس، ولتحول الانطباعات إلى معرفة، والتركيز على التجربة، التي لها أدوات ومستويات وتطورات في أجهزتها والتي تغدو ملغيةً لمعلوماتٍ وآراء سابقة نظراً لهذه الصلة بين المُعطى والتجربة.
لهذا تغدو العلومُ الطبيعيةُ منفصلةً عن الفلسفات والأديان والآراء المسبقة، وتغدو الفلسفات مستفيدة من خلاصات هذه العلوم ومستثمرة لها في وجهات نظرها.
من الممكن أن يكون هؤلاء الباحثين مثاليين ودينيين وماديين من مختلف التيارات، بسبب أن نشؤ العلوم في الغرب جاء من وعي مسيحيين ويهود ومؤمنين عامة، وهؤلاء حاولوا الارتقاء بالعلوم وعدم الاصطدام مع أديانهم وحجموا دلالات ونتائج العلوم وربطها بالصراعات الاجتماعية. لكن لينين ينطلق من رؤية حادة لإزالة الأديان والإستغلال بدون وعي علمي حقيقي، فيؤدي لتجربة مغايرة لما يريد.
خذ مثلاً ما يقوله لينين نفسه عن الأثير وعلاقته بالوعي:
(وهذا يعني إنه توجد خارج عنا، بصورة مستقلة عنا وعن إدراكنا، حركة للمادة، مثلاً، موجات الأثير ذات الطول المعين والسرعة المعينة، التي يولد في الانسان، بتأثيرها في شبكة العين، الإحساسُ بهذا اللون أو ذاك)، ص 54.
إن حركة المادة العامة المجردة هذه صحيحة التأثير غير أن(موجات الأثير) هذه غير موجودة في الطبيعة نفسها، أي أن هذا المصطلح من مفردات مدرسة علمية قديمة تم تجاوزها فلم يعد هناك شيءٌ أسمه موجات الأثير! لقد جرت تجارب علمية في أواخر القرن التاسع عشر أثبتت غياب هذا المُسمى، وبدأت نظرياتٌ علمية جديدة، ولكن مع غياب متابعة لينين:
(لقياس سرعة الموجات الكهرومغناطسية، قام ميكلسون ومورلي بإجراء تجربتهما الشهيرة سنة 1881وقد كانت هذه التجربة من أشهر التجارب في القرن التاسع عشر، والتي أدت إلى ثورة علمية لأن نتائجها كانت تعاكس تماما أفكار الباحثين المؤيدين لفكرة الأثير).
بطبيعة الحال إن العديد من باحثي النقدية التجريبية مثاليون ومحافظون وبينهم باحثون مناضلون في نقد وتحليل العالم الطبيعي والاجتماعي كذلك، لكن التعددية وإستثمار العلوم ونتائجها وتطويرها بالنقد يخلق شبكات تحليل واسعة للحياة في مختلف جوانب المعرفة.
يولي لينين أهميةً كبيرة لرجل الدين باركلي بإعتباره مشابهاً بشكل كلي للعلماء الفزيائيين والمنظرين النقديين التجريبيين، أصحاب هذه الفلسفة الجديدة التي قام لينين بمواجهتها في سنة 1908 في كتابه(المادية والنقد التجريبي).
(إن بريكلي يقول بكل جلاء إن المادة(جوهر لا وجود له)، ص 21.
يعتبر لينين ذلك بمثابة(الهجوم المقدس على المادة)!
إن رجل الدين المثالي هذا في تصوره يماثل أرنست ماخ الباحث من القرن التاسع عشر الفيزيائي المعروف.
لكن ثمة فرق هائل بين القس بيركلي والعالم ماخ!
فمن هو بريكلي هذا؟
جورج بيركلي (مارس 1685 – 14 يناير 1753) كان فيلسوفًا بريطانيًا-إيرلنديًا وأسقفا أنجليكانياً يعتبر من أهم مساندي الرؤية الجوهرية في القرن الثامن العشر الميلادي، ادعى بيركلي انه لا يوجد شيء اسمه مادة على الإطلاق وما يراه البشر ويعتبرونه عالمهم المادي لا يعدو أن يكون مجرد فكرة في عقل الله. وهكذا فأن العقل البشري لا يعدو أن يكون بيانا للروح. قلة من فلاسفة اليوم يمتلكون هذه الرؤية المتطرفة، لكن فكرة أن العقل الإنساني، هو جوهر، وهو أكثر علواً ورقياً من مجرد وظائف دماغية، لا تزال مقبولة بشكل واسع. آراء بيركلي هُوجمت، وفي نظر الكثيرين نُسفت)، موسوعة ويكيبيديا.
إذن بيركلي صاحب رؤية دينية متطرفة ألغى من خلالها العالمَ الموضوعي، وأعتبرهُ مجردَ فكرةٍ إلهية، وهو إمتدادٌ للعصور الوسطى والوعي الكَنسي التقليدي، ولهذا فهو يختلفُ إختلافاً كبيراً عن إرنست ماخ الذي عاش في القرن التاسع عشر باحثاً:
(ماخ، إرنست (1838 – 1916م)فيزيائي وعالم نفسي نمساوي درس حركة الأجسام بسرعتها القصوى خلال الغازات، وطوَّر طريقة دقيقة لقياس سرعتها معبرًا عنها بسرعة الصوت. وتعتبر هذه الطريقة مهمة خاصة في مشاكل الطيران الأسرع من الصوت. ظل عمل ماخ مبهماً إلى أن بدأت سرعة المركبة الفضائية تقترب من سرعة الصوت. وبعد ذلك استُخدم مصطلح رقم ماخ مقياساً للسرعة.)، المصدر نفسه.
وهو(يـُذكرُ باسهاماته في الفيزياء مثل رقم ماخ ودراسة موجات الصدم. كفيلسوفٍ للعلوم، فقد كان له تأثير كبير على الإيجابية المنطقية ومن خلال انتقادهِ لنيوتن، الذي مهّد لنسبية أينشتاين).
تتعدد وجهات نظر لينين تجاه ماخ ورؤيته، فيقول(التصور العام للماخيين ضد المادة) ص16،( الأسقف بركلي يساوي الماخيين)، ص35، وأتباعه يحاولون(تمرير المادية خلسة!)، (حاول أن يميل صوب المادية).
إن علماء الطبيعة يقومون بتنحية المُسبقات المختلفة، ومنها الأفكار، والتصورات القديمة عن المكان والزمان والمادة، وقد يقعون في أخطاء فكرية في هذا الهدف، ولكنهم يلجأون لذلك من أجل البحث العلمي، وعملية التنحية تبدو للينين بمثابة خيانة، ومن هنا يقوم ماخ بالبحث الجزئي المتغلغل في الظاهرة المدروسة للوصول إلى معرفتها والسيطرة عليها تقنياً، ثم يقوم بإختراعاته الكبيرة لكن فهمه النظري المادي الجدلي محدود.
(إن افيناريوس ينعتُ بالبحث المطلق ما يعتبرهُ ماخ صلة (العناصر) خارج جسمنا، وينعت بالنسبي ما يعتبره ماخ صلة العناصر التابعة لجسمنا)، المادية ص61.
إن افيناريوس هو عالمٌ مماثلٌ لماخ أقتربَ من رؤيته، وهو يعتبر الطبيعة التي هي العناصر خارج الجسم وبالتالي هي مطلقة، ولن تكون هنا في مجال البحث، لكن العناصرَ التي تدخلُ البحثَ هي متأثرة بوعينا ومستوى إدراكنا فهي نسبية.
كانت ثمة ثورةٌ علميةٌ تجري في أوربا من أجل الإطاحة بمفاهيم الفيزياء التقليدية، ومن أجل تصور جديد للمادة والكون، وهو تصورٌ متراوح متذبذب جزئي محدود لدى كل من ماخ وافيناريوس لكنه يظهرُ بصورته الكبيرة المادية الجدلية لدى انشتاين.
إن التجريبية النقدية المرفوضة عن لينين كانت تغيرُ العلومَ، لكنه كان لا يزالُ مع فكرة موجات الأثير، التي قامتْ تجربةُ العالِمين ميكلسون ومورلي بدحضها، سنة 1881 كما ذكرنا آنفاً في حين كتبَ لينين كتابَه سنة 1908، وطبعَهُ مرة أخرى بعد الثورة الروسية دون تغيير في فهمهِ لموجات الأثير، فتلك التجريبية أكدت أهمية دور العلماء الشخصي وتغييرهم لآراء سائدة مُسّبقة، قَبلية.
في مقابل واحدية الحزب المطلقة وهيمنة الدولة المطلقة يجري كذلك جعل المادية الجدلية مهيمنةً كلية، لكن الدكتاتورية هنا مُصّدعة للعلوم الطبيعية والاجتماعية على نحو خاص.
تتكشف في المساواة بين بريكلي والماخيين والتجريبيين المنطقيين عدم فهم لينين للتطور الاجتماعي الفكري العلمي ومراحله التاريخية ومسائل الديمقراطية وتعددية الاجتهادات الفكرية والفلسفية، ففيما يعكس بيركلي رؤية دينية صوفية رجعية يقوم علماءٌ من الفئات المتوسطة بتطوير العلوم مجتنبين الدينَ والمادية الجدلية الجامدة وقتذاك.
الوعي والمادة
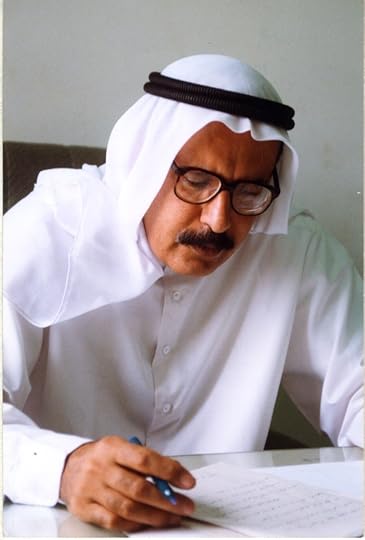
كتب : عبـــــــدالله خلــــــــيفة
جسد فهم المجتمعات للمادة، وهي الأشياء والعالم الخارجي الموضوعي، خارج العقل البشري، مدى قدرة البشر على السيطرة على الطبيعة والمجتمع، ومدى قدرتهم على التصنيع وخلق تراكم للعلوم الطبيعية والاجتماعية.
وقد بدأ العرب يقاربون الحضارة الحديثة منذ أن تفتحت عيون المثقفين في النهضة الحديثة، ومن ثم راحوا يراكمون وعياً جديداً مختلفاً عن (المادة) منذ الأنظمة الملكية الليبرالية فالأنظمة العسكرية الوطنية والثقافة التنويرية العلمانية وراح يتصاعد بتقطع وضعف دون أن قطع بجذورهم الإسلامية والقديمة والإنسانية.
وهذا التصاعد والتقطع والاستمرارية تعبر كلها عن حصيلة الصناعة والعلوم والحرية وعن جذور ضعيفة في حفر الأرض المادية.
لقد كان الحصول على معنى المادة ومعنى العلم وكشف سببيات الوجود لتلك القبائل التي خرجت من الجزيرة العربية أمراً صعباً محفوفاً بالمخاطر ولجماعاتٍ أميةٍ محدودة الأرث العلمي، والتي إنتجت منها فئات وسطى حرفية وثقافية في ظل الإمبراطورية وراحت تتساءلُ عن معنى الوجود وكيفية فهمه وكيف السيطرة عليه؟
إن الشعوبَ لا تفهم الطبيعةَ والمجتمعَ بشكلٍ مجرد سحري غيبي تلقائي عجائبي بشكلٍ أساسي، وإن كانت هذه هي المراحلُ الدنيا لتشكلِ العقول، لكنها تتجاوزها، لأنها ذات مستويات دنيا، ولاعتمادها على الحدس وهو أدنى أشكالِ الفكر وعلى التجارب البسيطة غير المعللة وغير المجربة تجريباً حديثاً.
لكن هذه الأشكال الدنيا ملاصقة كثيراً للعرب والمسلمين لأنهم في المستويات الدنيا من الإنتاجين الصناعي والعلمي، ومن هنا فالأشكال الأخرى من السحر والدين غير العقلاني تبقى مترافقةً مع هذا التطور ذي المستوى المنخفض.
ومن هنا كانت الجهود الجبارة للعلماء العرب والمسلمين في إنتزاع أسرار الطبيعة والمجتمع، وهم في بدايات الحضارة، وهو أمر مهدهُ علماءُ اللغةِ والكلامِ ثم الفلاسفة، الذين وضعوا جميعاً القواعدَ الأولى لبناءِ العقلية العربية الموضوعية النقدية، التي تراكمُ لبناتِ المعرفةِ الموثَّقة، والتي تكشفُ خلايا المادةِ وعملياتِ التغلغلِ فيها بشتى أشكالِ تمظهراتها، سواءً كانت جسم إنسان أو حيوان أو أشياء مادية بمختلف حالاتها، أو كانت كوكباً أم نجماً.
ولا تنفصلُ العلومُ الإنسانيةُ هنا عن العلوم الطبيعية، بل كانت هي مقدمتها، فتطورُ علومِ النحو والصرف والبيان ودراسة جذور اللغة وحياة العرب الاجتماعية، قادَ إلى وضعِ لغةٍ كبيرة ذات إمكانيات تعبيرية وإشتقاقية حيوية تحت تصرف علماء الطبيعة والرياضيات والطب والفلك والكيمياء وغيرهم.
فتغيرت الرياضيات بداية من تغيير الأرقام إلى جعل الصفر فيها وجعلها بالتالي سهلة ولا نهائية الحساب، لأن المادة لانهائية، وعبر الجبر تم إظهار الكم المجهول من الكم المعلوم، فغدت الرياضيات أداةً أخرى، وتطورت الهندسة الأقليدية، خاصة عبر التلاقح مع الثقافة اليونانية، ثم بدأت الكيمياء والفيزياء بالتطور مع تطور الحرف والصناعات.
لكن هل تنفصل العلوم هنا عن الشعوذة خاصة مع هذه النشأة الأولى الضعيفة؟
(أخذ جابرٌ«بن حيان» مادة الكيمياء – كما هو معلومٌ – من مدرسةِ الإسكندرية التي كانت تقولُ بإمكانيةِ انقلابِ العناصر وتحولها بعضها إلى بعض، وأخذ مع هذه الكيمياء فيضاً من الفلسفة الهيلينية والآدابَ السحريةَ والتصوف والروحية الإيرانية)، (الجامع في تاريخ العلوم عند العرب، الدكتور محمد عبدالرحمن مرحبا، منشورات عويدات ط2، 1988، ص 315).
إن إمكانياتِ الوصولِ إلى الأبعادِ المتعددة للمادةِ مسألةٌ مرهونةٌ بقوى الإنتاجِ السائدة في المجتمع وتجلياتها في البحثِ العلمي خاصةً مدى تقدم الحرف ومن ثم وجود معامل الإختبار، وظهور وتعمق تخصصات العلماء، وتنوع أدوات السبر والصهر والتحليل المختلفة.
ولهذا فإن حدوثَ جدلٍ عميقٍ بين الصناعة والعلوم لم يحدث:
(مزجَ العلماء العرب والمسلمون الذهبَ بالفضة، وإستخدموا القصديرَ لمنع التأكسد والصدأ في الأواني النحاسية، وإستخدموا خبرتَهم الكيمائية في صناعةِ العطور ومواد التجميل وصناعة الأقمشة والشموع..) الخ، الموسوعة العربية العالمية، ص 460.
لنلاحظ هنا كيف أن منهجيات البحث العقلي كانت محدودة وكذلك فإن توجه الطبقات الحاكمة للاستئثارِ بجانبٍ كبيرٍ من الفيضِ الإقتصادي، وجهَ الصناعات نحو الصناعات الاستهلاكية التابعة للقصور وكبارالتجار، مثلما أن الحركة الفلسفية لم تقمْ بتحليلات عميقة للمواد الطبيعية والاجتماعية.
إن المادة هنا باعتبارها مواداً وكواكب ونجوماً، أي مادةً كونيةً، لم تتغلغلْ الأبحاثُ فيها، فجثمت أشكالُ الوعي العربي العلمية على سطوح المواد والعمليات، وهي الموادُ المقاربةُ للاستهلاكِ أو للصحةِ الجسدية البسيطة، أو للتنجيم، وهو الثقبُ الأسودُ الذي إنهالتْ فيهِ موادُ الخرافةِ الواسعة وبلعتْ العقولَ والحضارة العربية.
وحتى شبكة العلوم الطبيعية كانت خاضعةً لأهدافِ الطبقاتِ العليا، فالطبُ والتنجيمُ والصيدلةُ يتمُ الصرفُ عليها، في حين لا تحظى علومٌ أخرى بمثل ذلك.
إن أشكال الوعي من دين وفلسفة وعلوم لم تستطع أن تصل إلى المادة إلا بمستويات محدودة وعجزتْ عن كشفِ تنوعاتِها والوصولِ إلى مكوناتِها الأصغر، وفي مختلفِ تجليات المادة الحية والجامدة على السواء، كما لم تصلْ – تلك الأشكال- إلى فهم عمليات المادة الأكثر تطوراً وهي الحياة الاجتماعية البشرية ونتاجها الأعمق وهو الظاهرات الفكرية.
ومن هنا فقدتْ مفاتيحَ إستمرار النهضة والتقدم وتوقفت وتخلفت.
إن أحجامَ إكتشاف المادة في الحضارتين الكبريين الإغريقية والعربية والحضارات الأخرى كذلك مثل الصينية والهندية، لم تصل إلا لكشف سطوح المادة، لكن في الحضارة الغربية التي تصاعدت منذ القرن الخامس عشر بدأت ظروف جديدة تتشكل، فقد أزيلت الدولة الكلية الإستبدادية وأُبعدت أحجارُ سيطرتِها وهي الأديان الكاتمة على حريات العقول وإنفتح المجال للتجريب العلمي الحر.
لكن ذلك إستغرق زمناً طويلاً وبتفاعل البُنى الاقتصادية والفكرية لكل المجموع النهضوي الغربي، بحيث تمَ تجاوزُ الحرفةَ، بظهورِ الصناعتين اليدوية فالآلية، والأخيرة هي الذروة ولأول مرة في التاريخ، وبهذا فإن المادة بمختلف تجلياتها الكونية والأرضية وُضعت تحت أصابع وعيون البشر لتفحصها، بشكلٍ تاريخي متدرجٍ يعكسُ تطورَ الصاعاتِ والملاحةِ وسيطرتهم على الأشياء والمنتجات والخريطة الأرضية.
إن الأجسامَ الفضائية كالكواكب والنجوم أُعيد النظر إليها، ورئُيتْ حركةُ الأجسام الكوكبية بشكلٍ صحيح، فبدأت المناظير تتجه إلى المواد الأصغر فالأصغر، دون أن يتوقف تحليل المواد الكبرى.
وهذه المراحلُ الأولى من الإكتشافاتِ الجغرافية والصناعة أعطتْ إقتراباً من الأجسامِ الفلكية الكبرى وساهمَ ذلك في إستعادةِ وحدةِ الكرة الأرضية، وبتواضعِ الأرض في المجموعة الشمسية لكنها صارت أقوى، ودخلتْ في تشكيلةٍ تاريخية جديدة هي الرأسمالية جعلتْ المادةَ البضائعية هي محور الاقتصاد والمعامل.
أعطت هذه المرحلة تغلغلات كبيرة في المواد الصناعية، فتمكن تشارلس داروين من فهم سببيات تطور الأحياء، وكشف كارل ماركس مادة البضاعة وتناقضاتها الاجتماعية، وهو مستوى لا يعود للبيولوجيا بل للعلوم الإنسانية، وتغلغل فرويد في فهم مادة العقل وطبقاته في الوعي واللاوعي إضافة لعلماء آخرين كشفوا جوانب أخرى من هذه المادة المُـفَّكرة، وهذه كانت ذروة العلوم في القرن التاسع عشر والثلث الأول من القرن العشرين.
في القرن العشرين تعرت المادة تعرية واسعة جداً، إتسع الكون إتساعاً عظيماً، ورُئي كمجراتٍ تشكلتْ في الانفجار العظيم، وهو الكون المرئي التاريخي لنا، أي كوننا، لأنه من الممكن أن تكون هناك أكوان أخرى، وكذلك فإن مادة هذا الكون دُرست وحُللت.
(المادة في الفيزياء الكلاسيكية هي كل ما له كتلة وحجم ويشغل حيزاً من الفراغ)، الموسوعة. لكن هذا هو الشكل الكلاسيكي للمادة فقد تداخلت المادة والطاقة، صارتا نوعاً واحد بوجهين.
وكما أن المادة لانهائية في الكبر فهي لا نهائية في الصغر، والحديث عن وجود حدود لها هو مجرد ظن:
(تتكون المادة من جسيماتٍ بالغة الصغر تسمى الجزيئات، وهي عبارة عن تجمعات لجسيمات أصغر هي الذرات. وتلك بدورها تتكون من جسيمات أصغر. ويُعتقد حالياً أن المادة تتكون من أجسام صغيرة جداً لا تتجزأ، حيث أنها لا تتكون من جسيمات أصغر بل هي أصغر شيء. وتـُسمى هذه الجسيمات بـ”الجسيمات الأولية”، ومع هذا فليس من المُثبت بعد أنها فعلاً أصغر الأجسام المكوّنة للمادة.)، موسوعة
كشفتْ المادةُ عن كونِها حركةً صراعية، فأجزاء الذرة الداخلية متضادة، دائبة الحركة، والمادة الطبيعية الكونية في صراع دائم بين مكوناتها وفي العلاقات بينها، وهي في حالة سيولة دائمة من الحركة.
المادة هي جزء من كوننا، ولا يُمكن إطلاق هذا المطلح على ما وراءه. ويُعتقد حالياً أن المادة تـُشكل 27% من كلتة الكون، 4% فقط هي المادة الطبيعية، والتي تنقسم إلى نوعين رئيسيّين: مادة مضيئة وغير مضيئة، وتــُشكل الأولى 0.4% من كتلة الكون، في حين أن الثانية تـُشكل 3.6% من كتله. أما الـ23% الأخرى فهي المادة المظلمة، والـ73% الباقية هي الطاقة المعتمة.
ليست قدرات العلوم الغربية وإمكانيات الثورة التقنية التي عصفت بالقرن العشرين هي مجرد إهرامات من الأفكار المجردة بل هي تحولات كبيرة في العلاقات الدولية قادت إلى إنقلاب أوضاع الدول وتأكيد الغرب لقيادته للمسيرة العالمية تبعاً لمصالحه ومن خلال موقعه المتميز، وبالعصف بنظم ماقبل الراسمالية والرأسماليات الحكومية الشرقية.
لقد برز صراع العلوم والثورة المعلوماتية والتقنيات الغربية في مواجهة وأمية العالم الثالث وتخلفه الثقافي ومحدوديته العلمية وتبلور في كونهِ صراعَ أساليب إنتاج وثروات تنتقل من جهة الشرق لجهة الغرب، فقد بلغ نسبة إنتاج العالم النامي 7% من الإنتاج الصناعي العالم، وبلغ حجم ديونه 2 تريليون دولار، رغم ضم هذا العالم النامي 70% من سكان العالم.
إن مجموع الارباح التى حولتها الاستثمارات الغربية لبلادها قد بلغ 139,7 بليون دولار خلال عقد 1970 – 1980.
فليست الثورة العلمية والتقنية هي مجرد أفكار مجردة، وليست هيمنة العلوم على المواد، هي أشكال ثقافية، بل سيطرة على المواد الخام، والاستثمارات والثروة المعرفية الجديدة.
إن عجز العالم النامي، ومنه العالم العربي، هو في أبنيته الاجتماعية – الثقافية المتخلفة، فعقلنة العالم وقراءاته السببية والقانونية، تترافق مع تغيير العلاقات بين الثقافة والتربية والتعليم وبين الإنتاج، مع تغيير الهياكل الاجتماعية الذكورية، مع تغيير الهياكل الحكومية البيروقراطية، مع الإنتقال للديمقراطية.
إن الثورة العلمية والتقنية الغربية تتغلغل كذلك في تغيير المواد التي ينتجها العالم النامي كذلك، فهي تطيح باقتصاده التقليدي كذلك:
(ومن الأمثلة على الصناعات التى قامت على الهندسة الوراثية (التكنولوجية الحيوية) والتى تم بها ايجاد منتجات تحل محل الانتاج الزراعي في العالم المتخلف التوصل الى انتاج النيلة(منتج صناعي يُستخدم في الصباغة) التى تنتجها الهند، وانتاج خيوط مخلقة لتحل محل السيزاك والمطاط، وانتاج حبوب الفانيليا بدلا من الطبيعية التى تنتجها مدغشقر وإنتاج حوالى ثلاثين بديلاً للصمغ العربي الذي ينتجه السودان)،(تاج السر.
إذا قرأنا هذه التحولات العاصفة الغربية وإنعكاساتها على المستوى الفكري، وربطنا بين إنهيار العقلانية العربية بعد ابن رشد، وعجز القوى الفكرية المختلفة عن العودة حتى إلى هذه العقلانية الفلسفية الدينية المثالية، فسوف نرى إنهيار المجتمعات العربية وعجزها عن الارتفاع لتحديات العلوم الغربية وثورتها المشار إليها، فغياب العقلانية الفلسفية يشير إلى عجوزات مختلفة؛ عدم القدرة على نشر التصنيع وخلق قوى عاملة متقدمة ماهرة تقنياً، وضعف وعي النساء وحضورهن التقني والعلمي، وهيمنة الثقافة السحرية على الوعي العام الخ.
أي أن الحضور العربي الراهن هو بسبب إنتاج المواد الخام الثمينة وأهمها البترول، الذي يجعل العديد من الدول العربية لا تعلن أفلاسها وإنهيارها الاقتصادي، ولما سببه البترول من حراك إقتصادي شمل دولاً عربية عديدة كذلك.
وقيام الاقتصاديات والأبنية الاجتماعية العربية على إقتصاد نفطي يؤكد غياب العرب عن ثقافة العالم المعاصر العلمية، وتشكل هذا العالم على الوعي غير العلمي.
فليس الوعي بالمادة كرؤية فلسفية مسألة تجريدية، بل تتعلق بصميم التطور البشري، فحين يرفض أبوحامد الغزالي السببية في زمن الثقافة العباسية، ولا تدخل هذه كرؤية شاملة في مختلف تجليات الظاهرات الطبيعية والاجتماعية، وأن لا تزال هذه الرؤية سائدة في الثقافة العامة، فهذا يظهر الفرق بين ثقافة غربية أحتوت عالم المواد وصنعتها كذلك وبين ثقافة لا تزال تعيش على الحرف وإنتاج المواد الخام.
لقد غدت هذه الثقافة الغربية التقنية تدخل إلى نسيج المواد وتغير تركيبها الطبيعي، وقد أمكنها صناعة الخلية الحية والقيام بالاستنساخ.



