محمد إلهامي's Blog, page 96
May 20, 2011
الهوس الغربي بالسيطرة على الإنسان - عرض ومناقشة كتاب
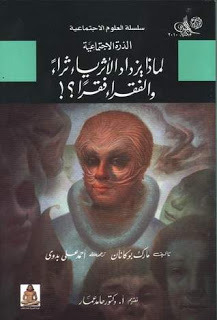
الهوس الغربي بالسيطرة على الإنسان
(عرض ومناقشة كتاب: الذرة الاجتماعية – مارك بوكانان)
اسم الكتاب: الذرة الاجتماعية؛ لماذا يزداد الأثرياء ثراء والفقراء فقرا؟
المؤلف: مارك بوكانان
المترجم: أحمد علي بدوي
الناشر: الدار المصرية اللبنانية (طبعة مكتبة الأسرة - القاهرة)
سنة النشر: 2010م
---------------
يحاول الكتاب تقديم تفسير جديد للسلوك الإنساني من خلال النظر إلى البشر من "زاوية أخرى"، إن هذا هو ما يجعل الكتاب يبدو شائقا مثيرا ومهما في أوله، ولكن ما يلبث سقف الطموحات أن ينخفض كلما توالت صفحات الكتاب حتى يتمخض الكتاب عن فكرة تبدو للقارئ الشرقي سطحية وبسيطة وربما تافهة.
ربما لو كنتُ غربيًّا لاعتبرتُ هذا الكتاب عظيما، وفي ظني أن هذه هي قيمة الكتاب الحقيقية: خروجه من الغرب وانطلاقه من أرضية فكرية غربية ليهدم فكرة غربية شائعة ثم ليبني غيرها، ولكنه يبنيها على نفس الأرضية الفكرية الغربية.. أما في أرضنا وعالمنا الشرقي (العربي والهندي والصيني وسائر الشرق) فلا يبدو الكتاب ذا قيمة كبيرة.
***
فكرة الكتاب متمثلة في أن الناس إذا نُظِر إليهم مثلما ينظر علماء الفيزياء إلى الذرات فإن كثيرا من السلوك البشري سيتم تفسيره بسهولة، مما يجعلنا على أعتاب علم جديد هو "الفيزياء الاجتماعية"، وهو علم سيُحْدث في الاجتماع طفرة تشبه ما صنعته ثورة "الكم" في الفيزياء.
لقد لوحظ أن الناس يتحركون جماعيا في "أنماط"، حتى مع اختلافهم في الأهواء والرغبات والميول، إلا أن ثمة مايجعلهم يتحركون في لحظة معينة تجاه موقف معين بسلوك واحد، هذه الحركة نفسها ما تلبث أن تؤثر على آخرين فتجذبهم إلى فعل نفس السلوك مما يزيد من قوة وعمق هذا السلوك، بهذا يمكن تفسير انقلاب كثيرين في لحظات معينة إلى طائفيين وعنصريين ودمويين، كما يمكن تفسير تطور مدينة بعينها من التخلف إلى التقدم بدون عامل استثنائي ظاهري، كما يمكن تفسير نجاح الشركات والمناطق الاقتصادية وغيرها.
لهذا ينبغي أن نبتعد عن محاولة دراسة السلوك الفردي لكل شخص على حدة في مثل هذه الظواهر، والاتجاه إلى دراسة "الأنماط"، لأن الخلافات بين الأفراد واسعة ومليئة بالتفاصيل وكثيرة التعقيد بينما دراسة الأنماط ستوفر كثيرا من التفاصيل غير المهمة ولا الضرورية لترصد كيف تتفاعل هذه المكونات البشرية الشديدة الاختلاف والمليئة بالتفاصيل حين تلتقي في جماعات، وحين تواجه –كجماعة- نفس المواقف.
إن هذا شبيه جدا بما تم في عالم الفيزياء، حيث إن نفس الذرات يمكنها أن تتجمع في أشكال متعددة، ويعتمد تكون المادة المتكونة من هذه الذرات على طريقة تفاعلها مع بعضها، فلهذا تختلف المواد النهائية وخصائصها باختلاف "سلوك" أو "نمط" الذرات في تفاعلها.
هذه هي الفكرة الرئيسية في الكتاب، والتي خصص لها المؤلف الفصل الأول.. ثم حاول في الفصول التالية أن يقدم ملامح الأنماط البشرية.
في الفصل الثاني وضع المؤلف عددا من حالات التحول الاجتماعي والاقتصادي التي تبدو غريبة، وتبدو أسباب نجاحها غير مفهومة، وضعها ليثبت فكرته القائلة بأنه لا تفسير لمثل هذه التحولات إلا بالنظر إلى "الأنماط"، وباعتماد نظرية "الذرة الاجتماعية" التي هي المدخل لعلم "الفيزياء الاجتماعية" في تحليل السلوك الإنساني.
حاول المؤلف في هذا الفصل أن يثبت أن الإنسان يخضع لقوانين علمية صارمة مثل التي تخضع لها الذرات في الفيزياء، وأن يرد على الاعتراضات التي قد يواجهه بها القاريء مثل: اختلاف الإنسان عن المادة، أو مثل وقائع تاريخية تثبت أن التاريخ –باعتباره حقل التجربة الإنسانية- لا يُتَنَبَّأ به كما يمكن التنبؤ بالتجربة في المعمل، وهكذا [والحقيقة أن هذا الجزء هو الأكثر تخبطا واضطرابا في كتاب المؤلف، ولكن سنمضي في العرض الآن ونؤجل النقاش والنقد بعد قليل]
وفي الفصل الثالث اهتم المؤلف بهدم الفكرة القائلة بأن الإنسان كائن عقلاني، أي يتصرف في كل أموره بعقلانية واضحة ويستطيع أن يحدد –بقرار عقلي بحت- أين تكمن المصلحة، وهي الفكرة المركزية في الفكر الغربي، وبنيت عليها كثير من الفلسفات والنظريات ولا سيما النظريات الاقتصادية، لقد استطاع المؤلف من خلال تحليل كثير من الحالات أن يهدم هذه الفكرة، مع التركيز على الحالات الاقتصادية باعتبار الاقتصاد هو النشاط الأبرز للحالة العقلانية.. يخرج القاريء من هذا الفصل وقد اقتنع أن الإنسان ليس عقلا فحسب.
وفي الفصل الرابع عرض المؤلف لفكرة "الذرة المُتَكَيِّفة"، وفيها يقول بأن الإنسان لديه القدرة على التكيُّف واستيعاب المستجدات، وناقش كيف أن هذا التكيف كفيل وحده بتدمير التنبؤات التي تُبنى على "العقلانية" وحدها، ثم كيف يكون هذا التكيف سبيلا لتفسير العديد من حالات التحول.
وفي الفصل الخامس عرض لفكرة "الذرة المُقَلِّدة" على أساس أن الإنسان يحاكي غيره في كثير من الأفعال وليس متخذا للقرار بعقلانية كما يتوقع المفكرون وعلماء الاقتصاد، وأن هذا التقليد يفسر كثيرا من السلوك الإنساني، فانتشار الشائعات –مثلا- هو أبسط تعبير عن هذه الخاصية الإنسانية، إذ يتناقل الناس بالتقليد أمورا لم يروها ولم تقم عليها دلائل، كذلك فإن الغريزة المقلدة هي التي تدفع لانتشار الاحتجاجات واتساعها حتى لو لم يكن المفجر لها قويا، فالإنسان بطبيعته يميل إلى الانسجام مع من حوله وقليل هم من يبذلون مجهودا لمخالفة التيار والتعرف على الحقائق بأنفسهم.
وفي الفصل السادس عرض المؤلف لفكرة "الذرة التعاونية" مثبتا أن الإنسان يميل إلى التعاون مع غيره من بني البشر حتى لو لم يكن يعرفهم، وحتى لو لم يكن هذا يعود عليه بالنفع، هذه المخالفة الصريحة للعقلانية المادية التبادلية التي تقوم عليها النظريات الاجتماعية الغربية وتظهر بوضوح في النظريات الاقتصادية ربما –كما يقول المؤلف- تكون من ميراث أجدادنا القدماء، لقد تأصلت فينا هذه الصفة حتى لو لم يعد لها مردود مادي.
وفي الفصل السابع يناقش المؤلف كيف أن الإنسان بطبعه ميال إلى التحيز والتميز والالتصاق بمجموعته، وبالتالي فإن لديه بذورا عدائية ضد "الآخر"، ولربما –كما يقول- كان هذا ميراثا من أجدادنا القدماء الذين اعتادوا على العيش في قبائل وجماعات متفرقة تعرف نفسها بالتميز عن غيرها ومعاداة هذا الغير، وبهذا يفسر المؤلف اندلاع النزاعات العرقية فجأة بعدما بدا أن الناس قد اعتادوا العيش في سلام، أو كيف ارتفعت شعبية بوش فجأة من الحضيض بعد هجمات سبتمبر، وبالتالي فإن القائد أو الزعيم السياسي ليس بالضرورة ممتلكا لمواهب فائقة ولكن هو ذلك الإنسان الذي لديه القدرة على اكتشاف وتوجيه طاقة العداء في قومه، فالسياسة هي "التنظيم المتوالي للأحقاد" كما يقول المؤرخ الأمريكي هنري بروكس آدامز.
وفي الفصل الثامن يأخذ موضوع الثروة كتطبيق لفكرة الأنماط، وكمثال ناجح لاستعمال علم "الفيزياء الاجتماعية" إذ سيَثْبُتُ أن ثمة قانونا كونيا ينظم توزيع السلطة بين الناس، هذا القانون الذي تفرزه الحضارات جميعا والشعوب جميعا هو الذي يجعل الأغنياء يزدادون غنىً والفقراء يزدادون فقرًا.
وفي الفصل التاسع أخذ موضوع المنافسة ونمط العمل في الشركات كتطبيق آخر لفكرة الأنماط، وخلص إلى أن حركة التاريخ تتكرر لأن القوانين تعمل وتعمل وتعمل ثم تعمل ثم تعمل حتى تعيد ترسخ أنماطا معينة إلى حد معين ثم يبلغ الأمر مداه النهائي فيتم الانقلاب لتعود الأمور سيرتها الأولى.
***
كان ما سبق هو العرض، وما يأتي هو المناقشة والنقد:
بدياة ينبغي التنبيه على أن الكتاب يمثل مراجعة جديدة للأفكار الغربية بخصوص الإنسان، وهو على هذا المستوى مفيد، إلا أن مشكلته الرئيسة أنه ينطلق من نفس الأرضية الغربية التي تجعل الإنسان جزءا من الطبيعة المادية، وعلى هذا فهو محكوم بقوانين مادية صارمة نحتاج إلى اكتشافها لكي نتحكم في الإنسان ونستثمره كما فعلنا مع الطبيعة.. لا وجود لاحتمال أن يكون الإنسان متفوقا على الطبيعة ومتجاوزا لها، إذ أن مجرد ورود هذا الاحتمال يدفع إلى الإيمان بالخالق الذي خلق الطبيعة وخلق الإنسان، وجعل هذه على طبيعتها المادية ومنح للإنسان طبيعة أخرى.
والمؤلف غير مستعد لمثل هذه الأفكار فهو مؤمن بالتطور وبالنظرية الداروينية لأصل الإنسان، وعلى رغم أن بحثه هذا قد أثبت له أن ثمة خصائص "إنسانية" لا توجد في المادة كالأخلاق التعاونية، أو التقليد والمحاكاة، إلا أنه عزا هذا سريعا إلى الميراث القديم الذي ترسخ فينا ووصل إلينا عبر أجدادنا الذين كانوا مضطرين للتعاون في ظروف تفرض عليهم أن يكونوا متعاونين وإلا خسروا جميعا. لقد أطال المؤلف في هدم "العقلانية المادية" التي تسيطر على الفكر الغربي، لا سيما الفكر الاقتصادي، حتى لقد قاربنا منتصف الكتاب وهو ما يزال يشبع هذه الفكرة هجوما، وكان حريا به بعد هذه الإطالة أن يفكر في التجاوز الإنساني للمادية الموجودة في قوانين الطبيعة، لا سيما بعد أن أتحفنا كثيرا بخصائص إنسانية بحتة.. إلا أنه لم يفعل، وذلك لفساد الأساس أصلا.
لهذا قد يكون الكتاب عظيما في بيئته الغربية، ربما يكون مفاجئا للغربيين اكتشاف هذه الغرائز إلا أنه على الأقل غير مفاجيء لنا نحن، فنحن الشرقيون (بمعنى الحضارات الشرقية) ما زالت تهيمن علينا عقائدنا التي تصرح بأننا شيء والطبيعة شيء آخر، وأننا متميزون بهذه الأخلاق التراحمية، والمؤمنون بالأديان السماوية يعلمون أن هذه الغرائز ليست لأننا ورثناها من أجدادنا القدماء، بل لأن فينا روحا من الله تجعلنا أسمى وأوسع من أن نكون ذرات مادية. ولقد أدى هذا إلى أن الشرق ما زال متحفا حافلا بالعديد من الأجناس والألوان والحضارات والعادات فيما تم تنميط المجتمعات الغربية تماما، ويمكن العودة في هذه النقطة لكتابات الفيلسوف الراحل د. عبد الوهاب المسيري، ومن ثم فلا أظن أن الكتاب مفيد للشرقيين إلا على مستوى معرفة الأفكار السائدة ومسار الفكر في الغرب.
كان أكثر الأجزاء تخبطا واضطرابا في الكتاب محاولته إثبات أن هذا العلم يمكن به السيطرة على السلوك الإنساني والتنبؤ به كما أمكن هذا بالنسبة للفيزياء في المعمل، لقد بدا مضطربا في الرد على الفوارق بين الإنسان والمادة وبين التنبؤ بالتاريخ والتنبؤ بالتجربة، ومارس نقضا لأقوال غيره بأكثر مما مارس إثباتا لأقواله، وبدا منشغلا بإسقاط نظرياتهم على رغم أن سقوطها لا يعني أن نظريته هي البديل الصالح.
وملحوظة أخرى تنتشر في الكتاب ولا تفلتها العين، تلك هي الغموض الذي يحيط بالتجارب التي تمت على الكمبيوتر، فالمؤلف يحكي كثيرا عن أمثلة قام بها العلماء في محاولة استكشاف السلوك البشري، فيذكر مثلا كيف تمت التجربة وكيف كانت نتائجها، إلا أن كثيرا من هذه التجارب لم يذكرها واكتفى بالقول بأنه بوضع هذه البيانات على الكمبيوتر أخرج لنا الكمبيوتر النتيجة التي تقول كذا، ولسنا نعلم كيف تمت "برمجة" هذا الكمبيوتر ليكتشف سلوكا إنسانيا؟!! ولهذا فإني من هذه التجارب والنتائج على شك.
***
إنها محاولة غربية أخرى للسيطرة على الإنسان وعلى التاريخ وتكريس التفوق الغربي من خلال التنبؤ بالمسارات الممكنة وتوجيهها أو الاستفادة منها، وهي في تقديري محاولة فاشلة أخرى، لأنها طلب ما لا يُدرك.
نشر في "مجلة الفسطاط التاريخية"May 16, 2011
فقه اختيار الرجال للأعمال (३)
أقر الإسلام منهج اختيار الرجال الأكفاء لإدارة الأعمال، وهو يقدم أهل الكفاءة على أهل الثقة، وقد رأينا –فيما سبق من حلقات هذه الدراسة- كيف اضطرد هذا المنهج في اختيارات النبي –صلى الله عليه وسلم- للمهام والأعمال المدنية والحربية، وكذا في اختيارات الخلفاء الراشدين لاسيما في أمور الولايات، ثم كيف تحول هذا المنهج إلى "ثقافة" تُمارَس بتلقائية، وكيف اضطرد المنهج في نقل الدين حيث اعتمد المحدثون معايير صارمة لنقل الحديث تقدم صاحب الحفظ والوعي على صاحب الدين إن كان ذا غفلة
May 14, 2011
من يزعمون امتلاك الثورة!
صدق الذي قال:
إذا لم يكن عونٌ من الله للفتى ... فأول ما يجني عليه اجتهادُه
ذلك أنه لولا فضل الله تعالى وتقديره وتدبيره ما كانت الثورات العربية قد اشتعلت، ولا كانت الثورتان المصرية والتونسية قد نجحتا، فلو أن البداية كانت من ليبيا أو من سوريا أو حتى من اليمن لما كانت الشعوب الأخرى ستفكر في ثورة!
ولو أن الثورة بدأت في مصر لكانت إقالة العادلي أو تغيير الحكومة أو تعيين عمر سليما نائبا كفيلاً بأن ينهي التظاهرات، ولَعُدَّ هذا نجاح كبير.
إلا أن البداية من تونس، ثم وصولها إلى إزاحة الرئيس، جعل المصريين لا يقبلون بأدنى من هذا، كذلك فإن انحياز الجيش التونسي ثم الجيش المصري للثورتين جعل نجاح الثورتين يحظى بالحد الأقصى من النجاح مع الحد الأدنى من الخسائر.
وفي الحالتين المصرية والتونسية كانت المشاركة الشعبية بطلا في المشهد لا يقل عن بطولة انحياز الجيوش، ذلك أنه لولا هذه المشاركة لكان منظموا المظاهرات في السجون أو على المشانق، بل لولا الذين وقفوا في اللجان الشعبية لكان قد تم تصفية الثورات من الخلف!
هذا فضلا عن تراث طويل من النضال والكفاح والتعرض للبطش والقهر والتعذيب والموت، فكل هذا الغرس كان يعمل في باطن الأرض وفي أعماق القلوب حتى جاء أجله.
أُذَكِّر بهذا لأن "الطواغيت الصغار" –كما سماهم الأستاذ فهمي هويدي- يظنون أن الثورة نبعت منهم ونجحت بهم ولولاهم وحدهم ما كان ثمة ثورات وعليه فيجب أن يُسَيِّروا الثورة كما شاءوا وأن تُنَفَّذ رغباتهم ورؤاهم، بل أن يُنظر إليها باعتبارها "أوامر واجبة التنفيذ".. كدت لا أصدق عيني حينما سمعت أحدهم يقول: "لن نتنازل عن أن يكون الانتخاب بالقائمة النسبية، هذا أمر خارج النقاش"!! وبعيدا عن تأييد الفكرة أو رفضها، حديثنا الآن عن هذه اللهجة التي تَدَّعي امتلاك ما لا تملك!
يساند "الطواغيتَ الصغارَ" مجموعةٌ من "الطواغيت الكبار" الذين لم تسمح لهم الظروف بأن يكونوا طواغيت، والحق أن رموز التيارات العلمانية والليبرالية تثبت كل يوم أنها ديكتاتور ذو قناع ملون، وأنها لا تستطيع الحياة إلا في رعاية الاستبداد لأنه الذي يتيح لها وجودا لا تستحقه ولا يمكن أن يتوفر لها في أجواء ديمقراطية.
لقد سمعنا من الطواغيت الكبار عَجَبًا؛ إحداهن أخذتها الجلالة فتحدثت عن "التصويت التمييزي" وفيه يكون صوت المثقف (وتقصد به نفسها ومن هم مثلها) ذا قيمة مضاعفة لصوت الأمي (لو أنها تملك لحرمتهم من التصويت والرأي باعتبارهم الرعاع والغوغاء والسوقة والسفلة).. غيرها أراد أن توضع مادة في الدستور تجعل الجيش وصيا على نتائج الانتخابات، فإذا أتت بالإسلاميين كان للجيش أن ينقلب على النتائج في استدعاء للنموذج التركي الشاذ الذي ما تقدمت تركيا إلا حين تخلصت منه.. واقتراحات أخرى لا مجال لسردها جميعا.
إلا أن اقتراحا بعينه ما يلبث أن يختفي حتى يعود، يقوله الطواغيت الصغار والكبار، ذلك هو "تشكيل مجلس رئاسي"، وهو الاقتراح الذي لاقى رفضا شعبيا كاسحا بالتصويت على الاستفتاء فتم بذلك إقرار الآلية التي تدير الفترة الانتقالية حتى وضع دستور وانتخاب رئيس للجمهورية.
لا يمل الطواغيت الصغار والكبار من إعادة المطالبة به بعد كل موقف أو حدث إلى الحد الذي يبدو وكأنه الحل السحري الذي غفلت عنه العقول، رغم أنه لا اتفاق على طريقة تشكيله أو صلاحياته كما أنه –عمليا- ليس إلا ستارا للحكم العسكري صاحب القوة الفعلية على الأرض!
إذا كانت مخلفات نظام يوليو كثيرة، فإن هذا واحدا من أخطرها، أن تكون ثمة "نخبة" قد نبتت على ضفاف الحكم المستبد الفاسد لا تحتمل أن يُقاس وزنها الشعبي فلا تأخذ أكثر منه، ولا تحتمل ألا تفرض على الشعب أفكارها، فهي تسعى لأن تصنع استبدادا جديدا يتيح لها الحياة والوجود، وسحقا لشعارات الحرية والدولة المدنية والمواطنة!
ورحم الله المتنبي إذ يقول:
ودهرٌ ناسه ناسٌ صِغَارٌ ... وإن كانت لهم جُثَثٌ ضِخام
ولو لم يَعْلُ إلا ذو محلٍ ... تعالى الجيش وانحطَّ القَتَام
May 8, 2011
.. وما يزال الأقباط مضطهدون!
نجيب جبرائيل، محامي الكنيسة، يطالب بتعيين لواء قبطي في المجلس العسكري، وعلى رسله يطالب آخرون بأن يكون نائب الرئيس قبطي!! ولا تسأل عن أقلية في كل العالم تطالب بمثل هذه الأمور.
على الجانب الآخر لا يطالب السلفيون حتى بأن يكون لهم عمود في الأهرام أو الأخبار أو الجمهورية أو روزاليوسف.. ولا تسمع أحدا منهم طالب بمنصب قيادي في الحكومة أو الجيش أو الشرطة أو المحافظين أو رؤساء الجامعات!!
ورغم هذا يقال بأن السلفيين منفلتين ويحتاجون للضرب بيد من حديد، وأن الأقباط مضطهدون.
أبو يحيى مفتاح فضل شاهد العيان على إسلام كاميليا شحاتة يتم سؤاله في تفاصيل تفاصيل التفاصيل حول شهادته بإسلام كاميليا، ويتم التشكيك في كل حرف يقوله، وفي الصور والوثائق التي معه رغم أنها قاطعة!
بينما يُراد للموضوع أن ينتهي بصورة يُخرجها نجيب جبرائيل، وفيديو تُخرجه الكنيسة، وظهور على قناة زكريا بطرس التي يحمل المسلمون نحوها شعورا عدائيا لما تتميز من سفالة في الخطاب.. ولا تجد إعلاميا يمارس مع جبرائيل عشر معشار العشر من التحقيقات في التفاصيل التي يمارسها مع أبي يحيى!
حين قطعت أذن قبطي في شجار عادي يحمل الطابع القبلي، أو حتى فليكن: يحمل الطابع الديني، تصاعد الموضوع للصفحات الأولى في الجرائد، وتم اكتشاف "حد قطع الأذن" في الإسلام، وصار الحديث عن الموضوع من صلب الحديث عن الدولة المدنية ومستقبل مصر والمساواة بين الناس وحق المواطنة!
لكن حين قتلت امرأة أسلمت على يد أهلها من الأقباط، لم ينشر الموضوع إلا في صفحة الحوادث!! ولم يشعر أحد أن الموضوع يمثل خطرا على الدولة المدنية أو مستقبل مصر أو ... أو ... إلخ.
وحين يُطالب المسلمون بخروج إنسانية يعتقدون أنها أسلمت، ولا يطلبون غير أن تمثل أمام النيابة في ظرف طبيعي لتقول ما تريد، ثم تؤيد النيابة طلبهم هذا.. فترفض الكنيسة، يكون الحديث الإعلامي متوجها نحو "لماذا تحرقون الوطن من أجل امرأة"، ولا يأتي على بال أحد مستقبل مصر والدولة المدنية والمواطنة!!
في الوسائل الإعلامية المصرية ثمة قداسة محفوظة للقساوسة وعلى رأسهم البابا، بينما لا احترام لأي شيخ آخر، فالكل يستطيع أن يكتب في الهجوم على أي عمة بداية من شيخ الأزهر وانتهاء بأي إنسان قرر أن تكون له لحية!
بل إن "قداسة" البابا محفوظة في الإعلام، أكثر من "قداسة" المشير طنطاوي، وأكثر مما كانت "قداسة" حسني مبارك!!
لكن.. النغمة الدائمة في كل الأحوال.. أن الأقباط مضطهدون!!
رغم أن الكنيسة فعلا فوق القانون، ولم تستطع حتى النيابة أن تستدعي كاميليا شحاتة، ورغم أن الكنائس فعلا مجتمعات مغلقة تمارس فيها كل الأنشطة ولا يُعرف لا على وجه الظن ولا على وجه اليقين طبيعة كل ما يتم فيها.
وما حدث في موضوع امبابة تتناوله روايتان رئيسيتان: رواية الكنيسة بأن سلفيين بلا سبب هجموا على الكنيسة بالأسلحة النارية، وهنا تصمت الكنيسة. والرواية الأخرى بأن فتاة أسلمت منذ شهور واختطفت في مارس الماضي واستطاعت بالأمس الاتصال بزوجها وإخباره بمكانها، فأخبر زوجها ائتلاف دعم المسلمين الجدد الذين سارعوا بالاتصال بالمجلس العسكري، ثم ذهبت قوة من الشرطة لاستطلاع المبنى الذي قيل بأن الفتاة محتجزة فيه والتابع للكنيسة، وتم الاتفاق على الدخول والتفتيش، وبمجرد الدخول بدأ إطلاق النار من داخل الكنيسة.
إن تصريحا مهما سيتجاوزه الجميع قاله وزير الداخلية (وهو ليس سلفيا) على قناة المحور بأن إطلاق النار بدأ من الكنيسة.
على أية حال، يمكن ترك القصة لتحقيقات النيابة، إلا أن السؤال المطروح الآن، أن الإعلام يحمل المسؤولية كلها لمن ادعى أن زوجته مختطفة، ويحكم بأنها شائعة مغرضة، ثم يدخل بالموضوع في المجال العائم الغائم والنقاش حول تطرف الأفكار والعقليات الطائفية والتحريض السلفي و.. و.. و.. إلخ.
والجميع يطالب بتوقيع أقصى العقوبة على صاحب الشائعة، لكن الغريب المثير للدهشة أن أحدا لم يتكلم في احتمال صدق هذا الرجل، ولم يتطرق ماذا لو كان صادقا، فما هي العقوبة التي يمكن أن توقع على من اختطفها واحتجزها بعلم ورعاية الكنيسة؟
إنني أرصد أن نفسيات المذيعين انطبعت تلقائيا حول تصديق أقوال الكنيسة والأخذ بها كمعلومات بينما تتعرض أقوال الجانب الإسلامي للتحقيق والتفسير والتفصيل والسؤال عن النوايا والأغراض والأهداف والطموحات.
وبين من يطالبون بلواء في المجلس العسكري ونائب رئيس قبطي.. وبين من لا يحصل على عمود أو برنامج في وسيلة إعلامية رسمية.. يظل –وياللعجب- يقال: الأقباط مُضطهدون!
ورحم الله يوما جاء فيه رجل إلى سليمان عليه السلام فقال: "إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب" (صدق الله العظيم)
May 7, 2011
ما أشبه المصالحة بالهدنة!
الحمد لله الذي جعل بعض الظن إثم، ذلك أن بعضه الآخر من محاسن الفِطَن، ولست أحب أن أكون من المثبطين أو المتشائمين، كيف وقد أخبرنا النبي أن من صفات المؤمنين الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يتطيرون.
كان يمكن أن نستبشر بالمصالحة بين فتح وحماس لو أن الفريقين من الوطنيين المجاهدين الذين تختلف وجهات نظرهم في قضية التحرير، إلا أن هذا –للأسف- ليس هو الواقع، فسلطة فتح ليست إلا وكيلا للاحتلال الإسرائيلي يقوم على تسيير الشؤون اليومية للفسلطينيين لا أكثر. ولهذا فإن الخلاف خلاف جوهري عميق.. هؤلاء يؤمنون بأن مسار التسوية قد فشل بعد عقدين من المحاولات، وأولئك يرون السلام خيارا استراتيجيا وأزليا لا محيص عنه.
ولئن كان عرفات الذي بدأ طريق التسوية يلمح أحيانا إلى أن فشل السلام سيدفع الشعب الفلسطيني إلى انتفاضة جديدة، فإن محمود عباس قد أعلن صراحة أنه لن يسمح بانتفاضة تحدث في عهده.. والحقيقة أن هذا التصريح هو –باصطلاح القانونيين- تصريح كاشف لا مُنِشيء، ذلك أن سياسة عباس تعتمد على التنسيق الأمني (الاسم الحركي للعمالة) مع الإسرائيليين ضد المقاومة، وسجون سلطة فتح تخلو من أي أسير إسرائيلي وتمتلئ بالمجاهدين، بل إن السلطة تسارع بإعادة من يقع أسيرا إلى إسرائيل، ولا تود إلا الرضا، ونظرة عطف، وبعض تجميد للمستوطنات!
لا ينبغي أن ننسى أن مصالحات في القاهرة ومكة تمت من قبل وفشلت، وذلك طبيعي، إذ أن أحدا لا يمكن أن يتصور مصالحة ناجحة بين طالبان وكرزاي في أفغانستان، ولا بين المقاومة العراقية وحكومة المالكي.. إنه خلاف جوهري وعميق.
إنما الذي حدث أن محمود عباس فقد ظهرا قويا بسقوط نظام مبارك، وأحب أن يلاعب الإسرائيليين الذين تركوه بلا ورقة يستهلكها داخليا، فإنه –وهو المنتهية ولايته- لم يستطع حتى أن ينتزع قرارا بتجميد بناء المستوطنات الإسرائيلية، وصار وجوده ذاته في موضع تساؤل، فما الذي يفعله عباس غير التصريحات والزيارات والاستقبالات.
لقد أحب عباس أن يُلاعب الإسرائيليين قليلا بورقة التقارب مع حماس، غير أن إسرائيل تعرف أنها حركات الأطفال الصغار الذين لا يملكون غير البكاء، والبكاء لا ينفع في السياسة، فليس يملك عباس أن يفعل شيئا آخر، وهو يعرف جيدا أن إسرائيل يمكنها أن تحبسه في المقاطعة وتقتله أيضا، وما عرفات عنا ببعيد! وحيث أن عباس لا يجرؤ على التعرض لمصير كهذا –بخلاف قادة حماس الذين لا يتهددون بالموت- فإن اللعبة ستجري في السياق الممكن والمقبول إسرائيليا حتى إشعار آخر.
لقد بدت هشاشة المصالحة أثناء توقيعها، فما أبعد ما بين خطاب عباس وخطاب خالد مشعل، بل إن خطاب عباس لم يسلم من مقاطعات لرمضان شلح رئيس حركة الجهاد بخصوص حق العودة وغيرها من الأمور الغامضة.. إن إلغاء البث المباشر لخطابات المصالحة وإذاعته مسجلا هو في ذاته دليل على أن المصالحة كانت مهددة بالفشل حتى اللحظة الأخيرة!
إنها في الحقيقة هدنة، هدنة مؤقتة، سُمِّيت مصالحة لأسباب عملية أكثر منها حقيقية، فلا عباس يمكن أن يتحول إلى المقاومة، ولا مشعل يمكن أن يتنازل عن القدس وحق العودة، ولذا فهي هدنة إلى حين وإن قيل عنها مصالحة!
وقديما طلب المحكوم عليه بالإعدام أن يُؤجل تنفيذ الحكم سنة مقابل أن يُعلم حمار الملك القراءة، فأجيب إلى طلبه ثم سُئل في ذلك فقال: بعد سنة قد يموت الملك أو يموت الحمار أو أموت أنا!!
إلا أن القضية الفلسطينية شهدت تحولا نوعيا منذ ظهرت حماس في ساحة السياسة، فمنذ تلك اللحظة بدأ المسار يتصحح ويعتدل، وطالما أن حماس تملك العقل والقوة فبوسع المرء أن يطمئن، فكيف إذا كانت تملك معهما الإيمان بالله والإخلاص للقضية!نشر في "شبكة رصد الإخبارية"
May 6, 2011
كاميليا شحاتة.. لحظة التاريخ لشيخ الأزهر
قال الدكتور محمد عباس: إن ثلاثة كان طول أعمارهم وَبَالاً عليهم: حسني مبارك، والبابا شنودة، وهيكل!
وهذا صحيح، فهؤلاء الذين جاوزوا الثمانين لو أنهم رحلوا في الستين لكان محبوهم أكثر بكثير مما هم الآن، فلقد كشفتهم السنون ورأوا في أعمارهم حصاد أعمالهم، والحمد لله رب العالمين.
أخشى أن ينضم إلى هؤلاء الثلاثة رجل آخر كشيخ الأزهر، ذلك أن الرجل وقعت في عهده سابقة لم تحدث في تاريخ الأزهر؛ جاءت امرأة إلى مشيخة الأزهر لتُسْلِم فعَطَّل الأزهر إسلامها، ووقف القساوسة على أبواب المشيخة لاعتقالها، ثم اعتُقِلَت بالفعل فيما بعد، وهي الآن محتجزة بعلم الكنيسة، هذا إن لم تكن قد قُتلِت.
لقد أبدى الشيخ الطيب مواقف طيبة بالنسبة إلى شيخ الأزهر السابق طنطاوي، وبدا أنه منحاز لإصلاح الأزهر -نسأل الله أن يعينه، والأيام تُصَدِّق النوايا أو تكذبها- غير أنه حتى لحظة كتابة هذه السطور ساكت تماما في مسألة كاميليا شحاتة التي شهد موظفان من "إشهار الإسلام" في الأزهر بأنها حضرت بالفعل وأرادت إشهار إسلامها.
إن الرجال مواقف يا فضيلة "الإمام"، وإنها لَسُبَّة أن يسجل التاريخ حدوث مثل هذا أثناء عهدك في المشيخة، وأفظع منه أن يسجل سكوتك لا سيما بعد أن انتهى نظام مبارك وما فيه من خوف! فأنقذ نفسك وتاريخك يا فضيلة الشيخ، واتخذ موقفا يُذْكَر لك عند الله وعند الناس.
على الجهة الأخرى، أشعر بالإشفاق كلما وضعت نفسي في موقف البابا شنودة، إذ يصدق فيه قول الشاعر:
ما كل ما يتمنى المرء يدركه ... تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن
وقد هبت على مصر رياح جعلت البابا في موقف لا يُحسد عليه، حتى أنه يمارس الكذب حفاظا على سمعته، بعد أن انهارت هيبته تماما وصار –ربما للمرة الأولى في تاريخ مصر- مُحْتَقَرًا من قبل المسلمين ويرونه عدوا لهم!
وبعد أن كان البابا يقول -بشجاعة كاذبة- لمن سأله عن مكان كاميليا: "وأنت مالك"، صارت الكنيسة تقول الآن "وأنا مالي! لا علاقة لنا بها".. وهكذا وقعت الكنيسة للأسف في خطيئة الكذب، وصار البابا في موقف لم نكن نتمنى له أن يضع نفسه فيه، ولكن ماذا نفعل إن كان هذا هو حصاد عمله وغرس يديه!!
حين نشرت المقال السابق "كاميليا شحاتة.. امرأة هزت عرش البابا"، تناقلته العديد من المواقع القبطية، مع إضافات في شتم كاتبه، إلا أن أحدا منها لم يرد عليه على الإطلاق ولم يتناوله بالنقاش، وصدقًا لا ألومهم فإنهم ضحايا، ولقد وضعهم رئيسهم الديني في موضع حرج وصاروا متخبطين بين تصديقه وتصديق عيونهم وعقولهم التي تأتيها الدلائل في كل حين.
والآن لا أريد أن تهتز "صورة شيخ الأزهر" بسبب كاميليا أيضا، (شيخ الأزهر لا عرش له كما للبابا) وعليه فإني أقترح عليه أمرين كلاهما يُدْخله التاريخ: إما أن يقف بصلابة في موضوع كاميليا شحاتة فيكون أول من يستعيد الأزهر عافيته على يده بعد عصور الاستبداد، أو أن يسرع في جعل منصب شيخ الأزهر بالانتخاب ويتخلى عن هذه المسؤوليات الجسيمة في هذا الوقت الصعب وحينها سيدخل التاريخ كذلك باعتباره الذي أعاد هذا النظام إلى الأزهر.
وأخيرا أتمنى له قولة المتنبي:
فلا عَبَرَت بي ساعة لا تُعِزُّني ... ولا صَحِبَتْني مُهجة تقبل الظُلْما
April 30, 2011
كاميليا شحاتة.. امرأة هزت عرش البابا!!
ليس من العجيب أن يكون أكثر المتضررين من سقوط نظام مبارك هم الذين كانوا مستفيدين من انهيار دولة القانون لحساب شبكة العلاقات والمصالح والتوازنات.. إلا أن المؤسف أن تضم هذه الفئة بطريرك الأقباط في مصر الأنبا شنودة.
من المؤسف كذلك أن "دولة الإعلام" التي نشأت في ظل نظام مبارك وبرعايته ما تزال قائمة بل وفاعلة وتمارس نفس التضليل والتحريض والافتراء، وهو دورٌ متجرد من المنطق فوق تجرده من الأخلاق، حتى إن المرء ليستدعي قول الشاعر:
وليس يَصِحُّ في الأذهان شيء ... إذا احتاج النهار إلى دليل
ثمة سيدة اسمها "كاميليا شحاتة" تحتجزها الكنيسة بغير وجه حق، ولا يُدرى عنها شيء، وثمة دلائل لا تقبل الشك على أنها أسلمت، والمطلوب من الأغلبية المسلمة أن تخرج هذه السيدة لتعلن في أجواء خالية من الضغوط حقيقة دينها فيرتاح الجميع.. إلا أن الكنيسة تصر على موقفها كما تصر على صمتها.
هذا الموقف مستفز، وهو –للطرافة- مستفز للأغلبية الكاسحة، وفي دول القانون لا يمكن لأزمة مثل هذه أن تحدث لأن القانون فوق الجميع، وأما في دول اللاقانون فإن الأقليات لا تجرؤ على استفزاز الأغلبية بهذا الشكل لأن الخلافات هناك تُحل بالمجازر والدماء.. يجب أن نسجل أن المسلمين في مصر يقدمون نموذجا فائقا لضبط النفس والحرص على الوطن.
لست أناقش هنا دور النظام البائد وأجهزته الأمنية الحقيرة في هذه الأزمة، فنحن –بإذن الله- سنرى عذابهم يوم القيامة، إنما نناقش دور الإعلام الذي يتجاوز كل هذه الأزمة ليركز على مشاهد في المظاهرات المطالبة بالإفراج عن كاميليا شحاتة، فيلتقط تصريحا هنا ولقطة هناك ولفتة هنالك، ثم يُسَوِّق المشهد على أن المسلمين (يسميهم السلفيين لمزيد من المراوغات والتشوية) يهددون ويتوعدون ويحذرون وينذرون وهم على وشك أن يفجروا فتنة طائفية وحربا أهلية!!
لا أحد يريد أن يسأل الأسئلة الحقيقية التي تحل الأزمة: ما سلطة الكنيسة في احتجاز الناس؟ لماذا يصر البطريرك على استمرار الأزمة وشحن المزيد من الغضب والاحتقانات؟
إذا كان "السلفيون" يُهاجَمون لأن الموضوع تافه ولا ينبغي إشعال الوطن من أجل امرأة واحدة، فلماذا لا يوجه هذا السؤال إلى الكنيسة؟ خصوصا وأن البطريرك يوصف بالحكمة والوطنية والعقل والحلم في مقابل السلفيين الذين يوصفون بالتوحش والشراسة والانغلاق وهم لا يتورعون عن قطع الآذان وشرب الدماء في روايات أخرى؟
فليتحل البابا بشيء من "الحكمة والحلم والعقل والوطنية" وليفوت على هؤلاء "المتوحشين" إشعال الوطن من أجل امرأة واحدة!!نشر في شبكة "رصد" الإخبارية
April 23, 2011
زمانك انقضى.. يا مصطفى!!
ربما بدا "مصطفى الفقي" رجلا مناسبا لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، شخصية بلا موقف، بلا تاريخ نضالي، متقلب بين الآراء، يحب السير في المنطقة الوسط، وكل هذا جيد فيما يخص هذا المنصب، فإنما هو منصب لا شرف فيه.
ولئن كان الناس استبشروا بعمرو موسى من قبل وحسبوا أن شخصيته -التي بدت ذات موقف يوم كان وزيرا للخارجية المصرية- ربما ساهمت في إصلاح الحال المائل بعد أمين عام بلا شخصية ولا موقف كعصمت عبد المجيد.. لئن كان الناس استبشروا فقد أثبتت لهم الأيام أن عمرو موسى لم يؤثر في المنصب بقدر ما أَثَّر فيه المنصب، أو لعله المنصب هو الذي كشف لنا شخصية موسى الحقيقية.
على كل حال، يمكن للأخ الفقي أن يكون مناسبا لهذا المنصب المثير للغثيان، غير أن الاعتراض عليه إنما ينطلق من سببين:
الأول: أن عهد مبارك قد انتهى، وهو رجل ربما كان إفرازا طبيعيا ومناسبا لعصر مبارك، ولربما لو كان مبارك قد رشحه للمنصب لما تعجبنا، أما مصر ما بعد الثورة فأمر آخر، فلا هو منها ولا هي منه، لا يناسب مصر التي ثارت أن ترشح سكرتير مبارك للمعلومات، ثم عضو البرلمان بالتزوير، ثم رئيس لجنة برلمانية للشؤون الخارجية (المباركية)، وقبل كل هذا وبعده مُنَظِّر لسياسة الحزب الوطني المنتهية ولايته وصلاحيته كذلك.. وصاحب المواقف المشينة من قضايا العرب (لا سيما ونحن لا ننسى له –مثلا- موقفه من الجدار الفولاذي!).
والثاني: أن العالم العربي قبل شهور غير العالم العربي بعد شهور، فلئن كان العرب القدامى يصلح لهم أمثال عصمت وعمرو والفقي، فإن العرب الجدد بعد نجاح ثوراتهم لا تناسبهم أمثال هذه الشخصيات.. إن الأنظمة الجديدة التي تفرزها ثورات الشعوب الحرة لا يناسبها العمل مع رجال الزمن القديم، ولهذا يبدو أن مثل هذا المنصب سيكون كبيرا ومتسعا على أمثال هذه الأنماط.
لا مانع أن أضيف سببا ثالثا ومعه اقتراح، ذلك أني فُجِعت حين شاهدت الفقي مع إيناس الدغيدي (مخرجة الأفلام المعروفة) في حوار يبدو فيه الرجل خبيرا بالرقص الشرقي وشديد الحماسة له حتى كاد أن يقول إنه واجب إسلامي!! ذلك سبب يدفعني لرفضه مرشحا، كما يدفعني كذلك لدعم اقتراح فيساوي (نسبة إلى الفيس بوك) ظريف بأنه يصلح أمينا لـ "شارع جامعة الدول" السيء السمعة في القاهرة.. مكانه هناك مناسب، وهذا الحوار خير دليل!!نشر في شبكة "رصد" الإخبارية
April 16, 2011
كيف نبني نظاما جديدا؟
 صورة من محاضرة سابقة
صورة من محاضرة سابقةأدعوكم لحضور المحاضرة التي سألقيها في "جمعية مصر للثقافة والحوار" يوم الأربعاء القادم 20/4/2011 وهي بعنوان:
"كيف نبني نظاما جديدا_ رؤية إسلامية حضارية"
تناقش كيف نستفيد من النموذج النبوي والتاريخ الحضاري الإسلامي في صناعة النظام الجديد الذي نرجوه لبلادنا.
يشرفني حضوركم، وأسألكم الدعاء، سواء من حضر أو من حبسه العذر :)
April 13, 2011
أنف كليوباترا وكف فادية!!
هذا ما يسميه المؤرخ البريطاني إدوارد كار "أنف كليوباترا"، على اعتبار أن ثمة شيء صغير يمكن أن يقع في لحظة ما فتتفاعل الأحداث في اتجاه غير متوقع، وضرب على هذا عددا من الأمثلة الطريفة، قال: "حينما امتنع القائد العسكري Bajazet بسبب إصابته بالنقرس عن السير إلى وسط أوروبا فإن جيبون لاحظ أن مزاجاً حاداً يصيب شخصاً ما قد يمنع أو يؤخر بؤس أمم عدة، وحين توفي الإسكندر اليوناني في خريف 1920 نتيجة عضة من قرد مدلل فإن تلك الحادثة افتتحت سلسلة من الأحداث (دخول اليونان في حرب مع تركيا) دفعت السير ونستون تشرشل إلى القول: إن ربع مليون إنسان ماتوا نتيجة عضة القرد تلك! أو لنأخذ تعليق الزعيم الروسي تروتسكي على الحمى التي أصابته حين كان يصطاد البط البري، وقد أصابته في لحظة حاسمة من نزاعه مع زينوفييف وكامنييف وستالين في خريف 1923 فقد علق قائلاً: بوسع المرء أن يتنبأ بثورة أو بحرب، ولكن يستحيل عليه أن يتنبأ بعواقب رحلة خريفية لصيد البط البري".
يمكننا أن ننسج الكثير على هذا المنوال، والتاريخ مليئ بأمثالها، فكم من حوادث صغيرة في لحظات فارقة كان لها أثر كبير.. إلا أن هذا السلوك للتاريخ الإنساني يدفع بالمؤرخ الغربي إلى الظن باستحالة التنبؤ بالتاريخ، لأن حوادث غير معروفة قد تأتي فجأة فتقلب كل التوقعات.
إنها لحظة بائسة يعيشها الفكر الغربي عامة، إذ يحاول الغربيون "السيطرة" على الإنسان والتاريخ والنفس، كما استطاعوا "السيطرة على الطبيعة والعلوم"، والمشكلة الأساسية وراء كل هذا وذاك هو الاعتقاد بأن الإنسان ليس إلا جزءًا من الطبيعة، وهو – لهذا – محكوم بقوانين علميَّة صارمة لا بد من اكتشافها وتسخيرها كما تم في حالة الطبيعة, المواد الخام.
وهذه المشكلة المزمنة التي تواجه كل من لا يؤمن بالإله ويعتقد اعتقادًا دروينيًّا في أصل الإنسان، لا نراها تواجه المؤمنين بالإله في عمومهم، فهم بالتالي يملكون إيمانًا بأنَّ الإنسان فوق الطبيعة وغير خاضع لقوانين المادة.
مشكلة "أنف كليوباترا" تُعيق الفكر الغربي عن التوصّل إلى طريقة تتيح "السيطرة على الإنسان" و"السيطرة على التاريخ".
بالتأمل في هذه المشكلة لاحظت مفارقة عجيبة، إن "أنف كليوباترا" في الفكر الغربي هي "قدرة الله" في الفكر الإسلامي، أو هي "الأمل في الله".. إن الشيء الذي يمثل مشكلة عند الغربيين هو ذاته الذي يمثل الأمل عندنا نحن الشرقيين؛ ذلك أن الحوادث والضوائق مهما بلغت صعوبتها وضيقها لا ينبغي أن تدفع بالمؤمنين إلى اليأس لسبب في غاية البساطة، أن الله يرى ويسمع ويقدر.
يا له من تفسير عجيب لقول الله تعالى "إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون".
قبل شهور فقط، من كان يظن أن صفعة من يد جندية (اسمها فادية حمدي) في مدينة تونسية هامشية على وجه عاطل يمكنها أن تحدث موجة ثورية هادرة تؤثر في العالم كله، فتقلب أوضاعا مستقرة منذ أكثر من نصف قرن، وتزلزل عروشا ظنها الناس لا تتزلزل.
إن الله يرى ويسمع ويقدر.. و"إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون".
ولَرُبَّ نازلة يضيق بها الفتى ذرعا … وعند الله منها المخرج
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت … وكنت أظنها لا تفرج
نشر في: يقظة فكر



