عبـــــــدالله خلــــــــيفة's Blog: https://isaalbuflasablog.wordpress.com , page 33
September 2, 2023
العودة إلى الينبوع
من الواضح أنه بعد هذه السنوات الطويلة من النضال الديمقراطى والوطنى البحريني، يصعب القول بأن التيارات السياسية السابقة يمكن أن تعود بعافيتها السابقة، وكأن شيئاً لم يحدث خلال تلك العقود التى استولت فيها قيادات فردية على هذه التيارات، أو تابعت فيها هذه التيارات أفكاراً تقدمية عالمية نضبت فيما بعد قدراتها، وتابعتها بدون إبداع محلي كبير.
ولهذا فإن المناضلين المخلصين، أي الذين لم يرتبط كفاحهم بالحصول على غنائم ما، مدعوون إلى قراءة تلك المسيرة السابقة، والفصل بين القمح والقشور، بين ما يبقى للناس وما يذهب جفاء.
وأهم ما صار رئيسياً هنا هي أن الهياكل القديمة، أي القنوات التنظيمية لم تعد قادرة على توصيل الفكر والرؤى إلى الناس، بسبب مرض انسداد الشرايين السياسية.
فالمناضلون تعبوا، ولم يعودوا بقادرين على التضحية، والأجيال الجديدة تائهة، والأسوأ من ذلك أن يروا بأن طرقهم هي الخيار الوحيد، وأن النضال الثقافي والإعلامي المفيد هو نهاية المطاف، حيث أن توصيل الأفكار إلى دائرة ضيقة مستمرة من الاصدقاء هو مهمة المرحلة الأساسية، في حين يبقى الجمهور العريض بلا ثقافة سياسية جديدة.
هذه الطريقة تعبر عن مرحلة من الكسل ومخاطبة الأنا، وغياب الحوار مع الجمهور وسيادة الحوار مع الأصدقاء، مع الشلة الصغيرة التى لا تكبر، وتظل الوجوه فيها هي نفسها، وتردد نفس الشعارات مع زيادة بند الأحداث اليومية والمستجدات.
والحوار مع الأصدقاء هو سهل ولكنه عقيم على المدى الطويل، فكأن النهر ينحصر في مجرى وحيد، عاجزاً عن التغلغل في شرايين الأرض، فيظل المرء يخاطب نفسه. وحتى هذه الحوارات الذاتية غالباً ما تكون محدودة بسبب غياب الإنتاج الفكري فيها، والاعتماد على الجاهز، وغياب الحفر والتحليل في خريطة الأرض الاجتماعية والاقتصادية.
إن الترهل السياسي، وتضخم السمنة التنظيمية، هي بسبب غياب الرياضة والنزول إلى الشارع، والجري في الأزقة، ومخاطبة الجمهور العادي وتثقيفه، واكتشاف عناصره الجيدة ورفد التنظيم بالكفاءات والكوادر الجديدة، ذات الصلة الحديثة بالجمهور وقضاياه، وهى التي من الممكن أن تجدد الدماء في العروق التي تكلست، وتطرد الشحم الذي سد المجرى، والأوشاب التي علقت في القنوات التنظيمية على مدى العقود الماضية، فقطعت صلة التنظيم بالناس، وأهم هذه الأوشاب هي الركون إلى الجاهز، والتعكز على القديم الذي بلي وتأسن.
إن العودة إلى الناس، والنزول إلى الأزقة، ومخاطبة البسطاء هي عملية صعبة، بعكس مخاطبة الأصدقاء الذين لا يحتاجون إلى تعب، والذين تتحول السياسة معهم إلى متعة وأنس، خاصة إذا دار الشراب، وعم اللهو، ولكن هنا تغدو السياسة مضيعة للوقت، مثل الدوران في الساقية نفسها، وهي لا تنتج مواد معرفية وسياسية وقيادات بشرية جديدة، بعكس الموقف من مخاطبة إنسان جديد، وخامة بكر لم تتشبع بألاعيب السياسيين وثرثرة المثقفين، وفي هذه الخامات كنوز النضال الحقيقي، والمواد التي شكلها الشعب في معاناته، ولم تتزركش بأردية ولم تتعفن من قنوات البث السياسي الصدئة.
لكن العمل مع هذه الخامات الشعبية يظل هو الأصعب والمحك، وفي تطويرها وصقلها عناء كبير، استراحت القوى السياسية من معاناته والدخول فيه.
إن الخطوط الفكرية القديمة، متطابقة مع الهياكل التنظيمية القديمة، وطرق الأداء السياسي فى مرحلة النضوب، في حين تتطلب المرحلة الجديدة أفكاراً جديدة، واقتراباً من وعي الجمهور، ولكن كيف تثقفه وأنت غير مثقف، وكيف تغيره وأنت بحاجة إلى تغيير ؟!
إن تغيير الجماعات الحديثة وتغيير الناس عملية مترابطة عبر تداخل الطرفين واغتنائهما معاً.
شجرة الياسمين : قصـــــــةٌ قصـــــــــيرةٌ
جاءتني الضحكة وأنا استعدُ للدخولِ في مملكةِ الظلام الدامس. جاءت وهي ترتعشُ بحزن الماضي وروعة المجهول الآتي، جاءتْ وقد بدأت آلامي تهدأ وأخذ الماضي يقودني نحو حديقته المزهرة بالدفء والراحة والأحلام.
سبق أن تتبعت هذه الضحكة خطواتي في عالم مترامٍ، زارتني في الحزن والسجن، في اليأس والمقبرة، في الكأس والرسم.. ولكنها اختفت في هذا الشتاء لتعاود الظهور هذه الليلة. إنها المرة الثانية التي تجيءُ فيها، إنها تنفجرُ في الظلامِ فكأن طفلاً يتسلقُ شجرة وهو يضحكُ ضحكة صاخبة، أو كأنها صبية تضحك ليلة عرسها. إنها قوية، مفعمة بالحرارة ودفء القلب صادرة من الأعماق التي تزهرُ فيها البراءة.
لو أنني القيتُ بهذا الدثار الثقيل، ولملمتُ أطرافي المتعبة، ونهضتُ لأرى وجهها الطفولي لما وجدتُ شيئاً. إنها تأبى أن تراني، ستختفي في مكانٍ لا يطالهُ أحدٌ، سترمقني بحبٍ وألم.
وكأنه ينتظرُ الإشارةَ، يلبسُ النومُ معطفَه، ويلقي عليَّ نظرة عجلى، ثم يغادرُ المنزلَ وهو يصفرُ ويدندنُ، متجهاً إلى عيون ليست كالجمر.
إنني أسمعُ خطواتها كأنها تمشي على رؤوس أصابعها، متجهة إلى شجرتها الذابلة. رغم الظلام ستراها، وستتلمسُ أغصانَها الجافة ثم تتأوه بحرقة. وها أنذا أسمعها وهي تقصُ على شجرةِ الياسمين حكاية الرجل العجوز، إن الشجرة تنصتُ إليها وقلبها الواهنُ لا يكادُ ينبضُ. إن عروقها يابسة، وأيديها كلها عظام. ستقصُ عليها كيف إنها لم تزر المنزل في هذا الشتاء، وكيف أن الرجلَ العجوز منعها من الدخول، ولكنها استطاعت أن تتسلل أخيراً. ولسوف تسقي الزرع جيداً، ولسوف تجعلُ الأزهار تنبثقُ أخيراً. كالأنوار والأحلام. ستبتسم الشجرةُ وسترمقُ وجهَ الفتاة المتلألئ كسنابل القمح ثم ستمدُ أيديها إلى الغيمِ الكثيف المتجمع فوقها وتعصرهُ فوق المنزل والأرض.. عندئذٍ ستشربُ بقدرِ سنوات القحط والموت والعطش.. وستنمو الأذرعُ ويتوردُ الوجهُ وتنبثقُ الزهراتُ كالنجماتِ والشهبِ والآمال..
وتنفجرُ الضحكةُ مرة ثالثة كرشرشة المطر فوق حقلٍ فتي. إن هذا الصوتَ لكائنٌ تتدفقُ عروقهُ بالدماء وليست بذكرى أو وهم. يجب أن أنهضَ. يجب أن أرى. وأقومُ متثاقلاً. أشعرُ بصدري يتقطعُ، ينتابني سعالٌ عنيفٌ، لكنني ألقي الدثارَ جانباً واتجهُ نحو الباب. افتحه فيغمرني الظلامُ والهدوء. لا أحدَ يتنفسُ. لا أحدَ يضحكُ. لا أسمع حتى رفرفة خفاش أو زقزقة عصفورٍ ضائع. صمتٌ عميقٌ كأني أفتحُ قبراً. أشعلُ النورَ فيستعيدُ المكانُ وجهَهُ المفقود، وأرى شجرة الياسمين العجوز وقد مدت أيديها إلى أجزاء المنزل فكأن عروقها الضامرة تحضنهُ وتقبله قبلة أخيرة.
2
كنتُ قد دفنتُ كتبي ودفاتري والقيتُ فوقها شيئاً من الحشائش والسعف وعزمتُ على قضاء يومي المدرسي في البستان المجاور للمدرسة، اتصيدُ الطيورَ وأقطفُ اللوزَ، حتى إذا سمعتُ جرسَ نهاية الحصة السادسة أسرعتُ مع العائدين من التلاميذ إلى البيت. ولم تكن اللعبة بجديدةٍ عليَّ فقد مرتْ أيامٌ كثيرة والبستان أو البحر أو المقبرة تشهد حضوري كأني جنيٌ صغيرٌ متمرد. ولكن في ذلك اليوم الربيعي ما كدتُ أخطو خطوتين قرب سور البستان حتى شعرتُ بقبضةٍ قاسية تشدني من كتفي. التفتُ مذعوراً فوجدتها أمامي كالهرة الشرسة وقد أُختطف صغارها. صاحت بي: أهذا ما تفعلهُ كلَ يومٍ؟! وعلى الفور قمتُ بعضِ يدها بقوة مذهلة حتى أحسستُ بالدم حاراً يفورُ في فمي. تركتني فأسرعتُ بدخولِ البستان ولكن كلَ شيءٍ كان في طريقهِ إلى التحول. كانت ثمة آلات وسيارات شحن وعمال كثيرون. كانت الأشجار تــُقطع، والبركة تهدم والأعشاب تجتث، والطيور تقتل. ووجدتُ كلَ الدروبِ مقفلة وإنه لا مفر من العودة. وقبل أن أخطو خطوة أخرى انهال عليَّ الضرب موجعاً حتى انهارت قواي. صحتُ وبكيتُ لكنها كانت تقودني إلى المدرسة بإصرار. وفي لحظة جنون أمسكتُ عباءتها ومزقتها. طالعتني بكره ضار فصاحت: ولكني لن أتركك! وجرتني بين التلاميذ، وفي ساحة المدرسة، ثم القتني عند غرفة المدير. والتمَّ عليَّ التلاميذ والمدرسون، وراحوا يتأملون ثيابي الممزقة ووجهي المنتفخ ودموعي المنهمرة.. ويبتسمون!
وفي المساء اقتربتُ من سريرها وكمنتُ لها في الظلام، وكلما أرادت أن تنامَ رفستها بقدمي. لم تهتم بي وواصلت رقدتها وهي تشخر وتصفر. وفجأة نهضتُ وصفعتها بقوة وأردتُ أن أقذف بنفسي من الغرفة لكنها أمسكتني وضمتني إلى صدرها، وعندما رأيتُ وجهها المبتسم يدعوني للدخول في بستان لا يُهدم أبداً، دخلتُ وأنا أرتعش بالبكاء والفرح.
3
رأيتُ وجهها وراء زجاج النافذة. وجهٌ لم يتغير كثيراً عن أيام الطفولة البعيدة الغارقة في بئر عميقة. إنها تبتسمُ ابتسامتها الرائعة وتدعوني إليها، لكنني مقيدٌ في هذا السرير الخشبي وفوقي لوحاتي تمنعني من النهوض. إنها صورٌ لجماجم متناثرة بشعة.. إنني أرتجفُ هلعاً، وأحاولُ القيام لكن سلاسل غير مرئية تشدني إلى السرير.
وتقولُ اختي: هيا تعالْ، أخرجْ. جاء الربيع وأنت مقيدٌ بهذه السلاسل.
أقولُ لها: سأنهضُ حالاً، لن يفوتني منظر الأزهار والفراشات والأطفال يلعبون في الجداول..
أحاول النهوض لكنني لا أستطيع. إن لوحة فيها صورة شجرة الياسمين وفتاة تضحكُ تمنعني من القيام. إنني لا أستطيع أن أمزقها، لأنها تدخلُ جسدي، وكلما حاولتُ تمزيقها وجدتُ إني أعصرُ أصابعي. وسمعتها تضحكُ ثم تغني للقمر. قالت للقمر إنها غادرتْ العالم صبية صغيرة. لم يقبلها شابٌ ولم يسمعها أحدٌ كلمات جميلة، فهل يقبل هو أن يتزوجها؟ ضحك القمرُ ثم قال إنه على موعدٍ مع امرأة عند الشاطئ. توقف غناؤها فجأة، سمعتها تبكي وتصرخ: الرجلُ العجوز! رحل القمرُ وحل الظلامُ والبكاءُ، وأنا مقيدٌ في هذا السرير الخشبي وفوقي لوحاتي ورسومها الكئيبة تنشرني بمنشارٍ صدئٍ له صوتٌ كالنعي. أحاولُ النهوضَ فلا أستطيع.. ويتمزقُ سمعي حين يصلني بكاؤها ممزوجاً بضحكاتِ الرجلِ العجوز!
4
وانتبه إلى النافذة تنفتحُ وتصدمُ الجدارَ بقوة. لقد أيقظني هذا الصوتُ من غفوتي وحلمي. من نومي الرائع وحلمي البغيض. ولكنني رأيتُ وجهها! إنها لم تزل تحتفظ بجمالها وتألقها، إنها لم تزل تحتفظ بضحكتها في جوفِ عالم دامس الظلمات. تعالي إليّ ايتها الصبية الضائعة في البرية. تعالي إليّ يا ضياء الياسمين وحزن السنين. لن ألمسك، لن أضربك، بل سوف أرسمك. سوف أرسمك بهذه الفرشاة التي اشتريتها لي. هذه الفرشاة التي كسرتها أمامك والصقتها بعد رحيلك. فأنا فنان أرسمُ بفرشاة مكسورة، وأنا فنانٌ أتنفس برئة منخورة. لو أنك فقط تحضرين هنا لرسمتُ لوحة الحلم. لرسمتك تغمرين السماءَ الزرقاء بأزهار الياسمين، وأنت تضحكين وتبكين، وأنت تلونين العالم بالضياء، وتدعين المحبين للعشق.. فلم تهربين مني؟ ولم تفرين عني؟ أيتها الفتاة المهجورة الهاجرة؟..
وأنتبه إلى دخول الرجل العجوز غرفتي بلا استئذان وبكل وقاحة. إنه صارمُ الملامح، غير مستعد لأية هدنةٍ مع الفرح. عيناه باردتان كقطعتي نقد، وشفتاه يابستان مطبقتان كحجر صلد. إنه يرصدُ الغرفة بنظراته، يقفُ قليلاً عند ساعة الحائط القديمة التي تركها أبي بعد وفاته. إنها صدئة، ولا ترن الرنين المعتاد، غير أنها ماضية في ضبط الوقت بلا توقف. ثم يحدقُ ملياً في اللوحة البيضاء الفارغة التي تقابلُ السرير والفرشاة العتيقة التي تنتظرُ قربها، والأصباغ المبعثرة كرجالٍ أقوياء عاطلين عن العمل.
إنه يجلسُ بكلِ برودٍ منتظراً مني مجموعة كاملة من الشتائم غير إني لا آبه به. وكالعادة يفتُح مغارته السوداءَ ويتكلم:
– لا تزال اللوحة فارغة وهذا شيءٌ يؤسفُ له. إن الأصابعَ كي ترسمَ لا بد لها من دماءٍ، وأنت نزفتَ دمك. فهذا وجهك أصفر، وعروقك بارزة مسودة، لم يبق فيك سوى العظام وهذه اللحية الكثة.. كيف يمكنك أن ترسمَ وأنت مجرد هيكلٍ عظمي، هيا غير طريقة حياتك، أنا مستعدٌ لإعطائك كمية كبيرة من المال حتى تصبح رجلاً ذا روح.
أتجهُ إلى اللوحة وأتناولُ الفرشاة. سأقضي هذه الليلة في رسم الحلم. لن أصغي إلى ثرثرة هذا الرجل وشكوكهِ التي يزرعها في كلِ مكان. هنا، في هذه النقطة السفلى من اللوحة، أبدأ برسمِ الجذورِ، جذور شجرة الياسمين.
يطالعني ويمضي في حديثه:
– أنظر إلى نفسك، إنك تتجهُ إلى الشيخوخة، وحتى الآن لم تتزوج. أنت وحيد.. وحيد، فراشك باردٌ، ولقمتك بلا طعم، ولذتك في مضاجعة الأحلام والأشباح. قل لي ما الذي أفادتك هذه اللوحاتُ الصارخة بالألم، الغاضبة، السوداء، المتوحشة..؟! تعالْ إليّ، سأعطيك النساءَ والأموالَ. سأوظفك في شركةِ دعايةٍ ما، أو أجعلك مسئولاً عن المسرحِ والمهرجين.. تعالْ إليّ ودعْ جذورَ الأشجار والضحكات الغامضة..
استطعتُ أن أرسمَ الجذورَ وقد تخللت التربة تخللاً عميقاً. لقد احتضنتها الأرضُ فاندغمتا معاً. نظر إلي العجوزُ بحقدٍ، ونهضَ هو غاضبٌ وصاح في وجهي:
– لن تستمر في هذا المنزل طويلاً، أنت لم تدفع الإيجارات منذ عدة شهور، وقد قررتْ المحكمة طردك منه. هيا أجمعْ حاجاتك ولملمْ أغراضك وغادرْ المنزل حالاً!
نظرتُ إليهِ بتحدٍ وقلتُ:
– لن أغادر بيتي ابداً..
– ستغادرهُ رغماً عنك. لقد قررت المحكمة طردك منه. سوف يتغير هذا المنزلُ تماماً. سوف أكنسُ هذه الأرض من بقاياكم ومن عواطفكم.. ستظهرُ عمارة كبيرة، سيسكنها أناسٌ في منتهى النظافةِ والأدب. لن تستمر هنا طويلاً يا عزيزي، فغداً سألقي بلوحاتك في عرضِ الطريق، وسأعطيك ساعة أبيك وقد توقفت عن متابعة الزمن تماماً، أما أغصان شجرة الياسمين الذابلة وجذورها الميتة فأعتقد إنك لن تحتاجَ إليها..!
– لن أغادر بيتي أبداً.
– غداً ستأتي الآلاتُ والسياراتُ والعمالُ ويزيلونه في لمح البصر، أما إذا بقيتَ فيه فأن أحداً لن يفرق بينك وبين أية حجارة منه.. وفي غمضةِ عين ستظهرُ العمارة الرائعة. سيسكنها أناسٌ أغرابٌ وسأفتحُ فيها خمارة صغيرة تسقي العطاشى والمتعبين..!
رمقتُ السماءَ فوجدتها سوداءَ لا ضوءَ يشعُ فيها ولا بريقٌ ينبعثُ منها كأنها رجلٌ التحف بأغطيةٍ سوداء كثيرة ومات. أنصتُ إلى المنزل الهادئ علَّ الضحكة تعودُ مرة أخرى أو علني أسمعُ الخطوات الرائعة تنبئ عن وجودها لكن الصمتَ كان يقيدُ كلَ شيءٍ ويربط كلَ فعل.. إلا هذا العجوز الذي أخذ يسير في أنحاء الغرفة وكأنه وضع يدَه أخيراً على المنزل وقبض روحَ الأسرة.
– أستسلم يا عزيزي بهدوءٍ فأنت وحيد بلا معين في هذا العالم الواسع، كل الناسِ الذين ترسمُ لهم لوحاتك غارقون في سباتهم أو منشغلون بتفاهاتهم.. هيا أستسلم وأحرقْ هذه اللوحات فلسوف تكسب كل ملذات الدنيا..
وأمضي في الرسم. أدخلُ جوفَ الحلم وأطبعُ في ذاكرتي رؤاه الغامرة بالنور.
وانتبه ثانية وإذا بالرجلِ العجوز قد اختفى! انهضُ وأفتحُ البابَ وأطالعُ الممرَ فإذا هو خالٍ وإذا بالباب الخارجي محكم الإغلاق وإذا بالصمتِ يلفُ كلَ شيءٍ ويغمرُ كلَ فعل.. ووحدها كانت هناك، الشجرة العجوز تحدقُ فيَّ كأم تنتظرني منذ أعوامٍ وأعوام!
5
دخلنا البيتَ الكبير ورأيناهُ على باب إحدى الحجرات ينتظرنا وهو مقطب الوجه، يتطلعُ إلى الطيور وهي تتقافز في أقفاصها مذعورة. وقفنا في الحوش، وجاء خادمٌ أسودُ البشرة وراح يحدقُ في الطيور ويهدئها قائلاً: «لا تخافي لا تخافي». أشار الرجلُ العجوزُ على أبي ثم دخل حجرته. تبعهُ أبي وهو يقودُ أختي إلى الداخل. أتت ترتجفُ خوفاً وبرداً، وعيناها زائغتان، ووجها أصفــّر وذبل. وما لبثا أن أختفيا في الحجرة. التفتُ نحو الخادم فرأيتهُ قد أخرجَ سكيناً ومضى يردد «لا تخافي أيتها الطيور، لا تخافي أبداً». كان يبتسمُ ويكشرُ عن أسنانه ويهزُ السكين كقطٍ جائع. فتح باب القفص وأدخلَ يدَهُ فراحت الطيور تهدل وتبكي بذعر. كانت تبتعدُ عن يدهِ فمضى يصرخُ غاضباً «أين ستفرين مني، سأقتلك!»، وأخيراً وضعَ يدَهُ على ما كان يبتغي، أخرجها فإذا هي حمامة بيضاء. ضحك بسرور بالغ وامتدت سكينهُ إلى عنقها، وفي ثانية واحدة قطعهُ لكن الحمامة المذبوحة قفزتْ من يدهِ فإذا هي تحت قدمي اختي التي كانت خارجة في تلك اللحظة. ذعرتْ وذعرتُ وانتابني خوفٌ غريبٌ، لأن الدماءَ لوثتها ولأن الرجلَ العجوز كان فوق العتبة يبتسم ابتسامة كأنها الموت!
6
قالت لي: تعالْ أزرعْ هذا الغصنَ هناك.
تطلعتُ إلى وجهها الذابل وعينيها الغارقتين في الظلام وتعجبتُ من أين أحضرت هذا الغصن ولماذا تريد أن أزرعهُ وهو جافٌ يابسٌ كعصا.
قلتُ لها: سأذهبُ إلى الملعب، وعندنا مباراة اليوم!
قالت: لن يستغرقَ ذلك منك وقتاً.
قلتُ: بل سوف يستغرق.. سوف ألبس ملابسي الرياضية الآن.
تركتها ورحتُ ألبس حذائي. رأيتها تتحاملُ على نفسها، تنزلُ من على الفراش ببطءٍ شديد، ثم تتجهُ إلى الحوش، وهي ترتجفُ سعالاً وبرداً. وقبل أن تبلغ المكانَ تعثرتْ وسقطت. سمعتها تئنُ. قذفتُ الحذاءَ جانباً وركضتُ إليها، ساعدتها على النهوض فقامت وسارت حتى وصلت الجدار الشرقي لمنزلنا. وهناك زرعتْ الغصن. ابتسمتْ وسالتْ دموعها. وراحت تدندنُ بأغنية لكن الأغنية كانت متقطعة، خافتة، واهنة.. أما أنا فقد لبستُ حذائي وأخذتُ الكرة وقفزتُ إلى الخارج!
7
جرني أبي إلى الباب ثم أعطاني قطعة نقدٍ وهو يقول:
– أذهبْ وألعب بعيداً..
خرجتُ فأقفل الباب. كان الرجلُ العجوز بالداخل، وهو يقرأ كلماتٍ غريبة من كتاب عتيق في يده. نظرتُ من ثقب الباب فرأيت أختي تتمدد على فراش والعجوز واقفٌ فوقها وهو يطلقُ بعض البخورَ ويفحص جسمها وعيناهُ تنفثان الشرر وما لبث أن ترك المبخرة جانباً وأخذ سيخاً مبيض الرأس. رأيتُ أبي يركعُ معه. رأيت العجوز ينحني أيضاً. لكن ما هذا الذي أرى؟ إنها تصرخ. تصرخ. تصرخ. إنهما يقتلانها. إنها تصرخ. إني لا أستطيع الوقوف هنا. إني لا أستطيع المكوث هنا. إنني أركض وأركض وأركض بعيداً. سرتُ وسرت حتى شعرتُ بالتعب يثقب صدري ويشل قدمي. سقطتُ على الأرض وتشبثتُ بالتراب. وعندما رفعتُ رأسي رأيتُ البستان القديم أمامي. لم أسمع عصفوراً يغرد أو جدول ما يغني. رأيتُ أبنية بشعة تتمددُ فوق كالوحوش. تحول البستان إلى بلاعة فاضت مياهها وانتشرت قذارتها في كلِ مكان. سمعتُ بكاءَ الأطفال وعويل النساء وضحكات السكارى والشتائم الحادة والكلمات الغريبة. وتصاعد البكاءُ العنيفُ ورأيتُ جنازة تتقدمُ نحوي. إنهم رجالٌ مسرعون يحملون نعشاً صغيراً يكادُ يطيرُ فوق أكتافهم. إنهم يتقدمون نحوي ويدمدمون كأنهم يتوعدون عدواً لا يرحم. إنهم يقتربون ولا يرونني. وأنا لا أقدرُ على النهوض. تمزق صدري وخارت قوتي. يقتربون. عليّ أن أنهض. عليّ أن أقفز. وهم يتقدمون.. عشرات الأرجل والأحذية والنعل.. حصى يتناثر وأصواتٌ تخضُ الأرضَ.. وحملتُ ثقلي وروحي وقفزتُ.. ولم ينتبهوا لشيء، ظلوا يتقدمون..
وحين حلَّ الظلامُ عدتُ إلى حينا. إن قلبي يرتجفُ كالحمامة المذبوحة. قلبي ينتفضُ وأنا أقتربُ من البيت. إن صوراً مفزعة تشدني من عيني وشعري. إن أسياخاً من الحديد المحمى تلهبُ جلدي ولحمي، وها أنذا أصل إلى البيت. وها أنذا أسمع البكاء والعويل. وها أنذا اسمعُ الصياح في كل مكان. البابُ مفتوحٌ على مصراعيه، والناس تبكي في الداخل. أصواتٌ تفقأ عيني وتثقب أذني وفتت قلبي. بكاءٌ. بكاءٌ. بكاءٌ. وهي كانت هناك! تحت شجرة الياسمين غطيت برداء أبيض وأغصان الشجرة تدلت عليها وراحت تقبلها بحبٍ لا يضاهي، وأنا لا أعرف ما العمل، أبكي وأصرخ وأريدُ أن أمزق شيئاً ما. أريدُ أن أقتل أحداً.
وانتبه لنفسي وإذا بي رجل كبير ذو لحية كثة ولوحة ناقصة، وإذا بشجرة الياسمين عجوز يتمددُ في كل جسدِ المنزل كالعروق، وإذا السماء من فوقي كالشيطان جالس بعباءته السوداء والصمتُ يغمرُ كلَ شيء فلا بكاءً أو عويلاً ولا أناساً ولا أكفاناً ولا أزهاراً.
8
جلستُ أمام اللوحة وواصلتُ الرسم. انطلقتُ إلى الوجه مباشرة، أريدُ أن أجعل الضحكة تنبثق كزهرةٍ لا تذبل. كانت يدي تعملُ بلا توقفٍ، والألوان تتجمعُ شيئاً فشيئاً مشكلة الوجه. فجأة أخذت يدي ترتجف واهتزت الفرشاة. هل يمكن أن أرسم الفرح؟ هل أقدر أن أصل إلى الضياء؟
في تلك اللحظة كنتُ أرمقُ السماء فرأيتُ البرقَ سيفاً يبتر معصمي وأضاءت البروقُ المنزلَ فخيل إليّ أن الشجرة ترقصُ في فرح. تناولت الفرشاة واندفعتُ في الوجه. صحتُ: تعالي أيتها الصبية القاطنة مملكة الصمت، انهضي من رقدتك الأبدية وسيري معي بضعَ خطوات. تعالي إلي فستكونين هنا، إلى الأبد، حيث لا موت ولا صمتَ، أنهضي!
وضاعت كلماتي في غمرة دويٌ عنيف هزَّ السماءَ، وتتابع قصفُ الرعد واهتز المنزل وانتفضت الشجرة مذعورة. سمعتُ هديراً وزئير غابةٍ من الوحوش، وأندفعَ الهواءُ رياحاً هوجاء من كلِ جهة. وبغتة تساقط المطرُ مدراراً. اندفع يضربُ الجدران والأبواب كجموعٍ هائلةٍ من الجياع. فتتابع قصفُ الرعد، وأمتشقت السماءُ بروقها وأضاءت الفضاءَ واكتسحت الظلام. وأستمر المطرَ في دقهِ على النوافذ يريدُ الدخول.
وخيلَّ إليَّ أن السقفَ يتشقق، والماءَ يتسربُ منه. وأصمني الضجيجُ وقيد الرعدُ ذراعي، وبصعوبة حررت يدي وواصلتُ الرسم فازداد المطرُ صخباً، وأشتد قصفُ الرعد، واهتزت النوافذُ وتأوهتْ الأبوابُ. وسمعتُ أغصانَ الشجرة ترتجف برداً ورأيتها تدقُ النافذة كأنها تطلبُ دفئاً وأماناً..
واصلتُ الرسمَ وشعرتُ بكياني كلهُ يتهدم وأصابعي عاجزة عن مسك الفرشاة لكن النهاية بدت على بعد خطوتين. خطوتان فقط وينتهي التعبُ، وهذه الضرباتُ الأخيرة ستحددُ كلَ شيء. وقبل أن أخطو خطوة واحدة رأيتُ السقف يتشققُ والماءَ يتسربُ إلى الغرفة. خطٌ من الماء يتسللُ إلى الداخل بلا توقف لكني لم أتوقف. قفزتُ خطوة واحدة فرأيتُ الضياء يلوحُ في نهاية النفق المظلم، وبعد أن نسيتُ كل ما حولي، فاختفت الضجة وتلاشت الآلام وتعب التعبُ مني، أطلقتُ كلَ روحي في الضربة الأخيرة وبعدها القيتُ بنفسي على الفراش منهاراً.
9
سمعتها تضحك ضحكتها الرائعة، ورأيتها تجري في حقلٍ من الأزهار والأنوار، رأيتها تلوحُ لي وتبعث قبلاتها السخية، غمرتني السعادة وتحولتُ إلى عصفور يغردُ وينفضُ الندى عن جناحيه فرحاً ولما سمعتها تدقُ على النافذة رفعتُ رأسي فوجدتُ نوراً خافتاً ينتشرُ في الغرفة وسمعتُ المطرَ يعزفُ على زجاج النافذة نغماً هادئاً راقصاً.
انتبهت إلى الصباح وقد اشرق والعاصفة وقد رحلت، والهدوء وقد خيم على الفضاء. كانت أرضُ الغرفة تبللت ماءاً ولكن اللوحة كانت فوق الطوفان. ورأيتها تلوحُ لي وتضحك، وأزهار الياسمين تحلقُ في السماء الزرقاء ورائحتها تغذي النورَ والهواءَ.
1977 ديسمبر ــ سجن (معتقل) جدا
September 1, 2023
كتابات عبـــــــدالله خلــــــــيفة : على موقع التغيير الديمقراطي – البحرين
الرابط أدناه: https://democraticchange-bh.org/dcb/category/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%D9%D9-%D8%AE%D9%D9%8A%D9%D8%A9/
August 31, 2023
علي بابا واللصوص : قصـــــــةٌ قصـــــــــيرةٌ
كتب : عبـــــــدالله خلــــــــيفة
1
العطرُ ينبعثُ من الأشجار والأحجار ، يتآلف مع زقزقة الطيور وندى الليل والأضواء المتراقصة على وجه النهر فيغدو كنشوة السكران أو كالحلم الأخضر ، وربما تحول إلى خنجر يقطرُ دماً أو حارة فقراء تحترق .
القصرُ يتألقُ في الليل بالأضواء الملونة وبموسيقى تنبعثُ من قاعة ما كأنها عزفُ ريح تتخلل غابة من النخيل . العزفُ يتوقف الآن ، والأضواء تتغيرُ ، تتحولُ إلى أضواءِ فجرٍ قريب . .
ليتَ الفجرَ يسرعُ بالمجيء . . لكن الفجرَ بعيدٌ . . بعيد ، وهذه الحراسة تعذبني كثيراً . عندما تشرقُ الشمسُ سأتنفسُ بارتياح ، سأعطيهم البندقية ثم أمضي إلى شاي الأختِ اللذيذ وموقدِها المليءِ بالجمر وإلى حكاياتِها الغريبة عن الحارة واللصوص . وربما لا أتوجه إلى المنزل بل أنطلق إلى «القهوة» رأساً . لن أقف هنا حتى لحظة واحدة ، سأجري ، بل سأطير لو استطعت . الوقتُ هنا يمرُ بصعوبة ، كأن عجلات سيارة تدهسُ صدري بكلِ مهلٍ وبطٍ ، فمتى ينبثقُ الفجرُ ويشتعلُ النهارُ بالفرح ؟ .
وبدلاً من الدفءِ التافهِ الذي تبعثهُ المصابيحُ قام أحدٌ ما في القصر بإطفاء الأنوار تماماً ، حتى نور عود كبريت واحد لم يبقهِ ، الليلُ أصبحَ دامساً ، وتحولَ إلى كهفٍ أسود قاتم .
إن هؤلاء الأغنياء يسهلون المهمة على اللصوص . فمن يدري ربما تسلل واحدٌ منهم إلى الداخل ، أو ربما عصابة كاملة . أظنُ إنهم لا يخافون اللصوص ، ولكن حين تتم السرقة سيهشمون رأسي أنا وحدي . لأنهض وأراقبَ السور .
الموسيقى تنبعثُ ثانية ، خافة ، ناعمة كقطةٍ صغيرة أو طفلٍ يبتسم في مهده .
لا تزال الأنوارُ غائبة ، فكأن أحداً يدغدغُ هذا الشبحَ الأسود فيجعله يصدرُ الموسيقى الحالمة . .
من يجرؤ على الاقتراب من قصر الخليفة أمير المؤمنين . هيا لأعود إلى مقعدي وأريحَ ظهري قليلاً وأحلمُ بالصباح . .
2
أمس قمتُ بزيارةٍ سرية إلى الغابةِ المتلحفةِ بالهدوءِ والظلام . تناولتُ بندقيتي وسرتُ بوجلٍ بين الينابيع والجداول والأشجار . رأيتُ النهرَ عن قرب . إن ماءهُ أخضر غريب . كأن السادة عذبوا الأشجارَ طويلاً حتى بكتْ هذا الماء . شربتُ من النهر ، ولقد خيل إليّ إني أرتفعُ في الهواء حتى تحولتُ إلى عصفورٍ يرفرفُ سعيداً بين الأشجار . رقصتُ في قلبِ النشوة والفرح . هكذا حضرتْ فجأة . إنها تهجمُ عليّ أثناء حراستي ، أما عندما أذهبُ إليها أو ألقي بنفسي في السوق فإنها تنامُ باطمئنان . هنا في القصر تنبعثُ من داخلي كالشوك . إننا نسميها واحة الأزهار . هي عبارة عن مجموعةٍ كثيفةٍ من أكواخٍ أقيمت – على عجلٍ – من حجرٍ وسعفٍ وأخشاب وجذوع أشجار وصفائح رقيقة من المعدن . طلعتْ كالفطريات في أرضٍ سبخة بعد حريقٍ شبَّ في حارتنا القديمة .
فكرتُ فيها كأنها زوجة مصابة بالسل أو بالسرطان ولكنها طلعتْ إليّ بأطفالِها وضجيجهم العنيف ، بمستنقعاتها . بنسائها الحوامل . بأختي العانس . بمصابيحها اليدوية وكلابها . الجميعُ اتجه نحوي . الجميعُ تحاوطني . عيونُ النساءِ والكلابِ تلمع . الأطفالُ أبرزوا سكاكينهم . اللصوص حملوا مشاعلهم .الجميعُ ضدي . الجميع حولي . إنهم يتقدمون ببطءٍ . إنهم يصرخون بعنفٍ ، ودفعة واحدة ، بالنار والسكاكين والأظافر ، يهجمون عليّ . أمسكُ شجرة وأخفي رأسي . أدفنُ عيوني في الظلام وأرهفُ سمعي للأصوات . إني أصرخُ : أيتها الأشباح دعيني في سلام ! لكن الغابة هادئة ، وثمة عصابة صغيرة من العصافير تغني ، والجدولُ القريبُ مني يسيرُ كقاربٍ من ورقٍ أطلقهُ طفلٌ . لا نساءَ حواملَ ، ولا أولادَ يمسكون السكاكين ، ولا كلابَ شرسة .
أنطلقُ ثانية وطنينُ الحلم يئزُ في رأسي كطائرةٍ حربية . سأشربُ الماء / الخمرة ثم أغني لليلِ وللنجومِ ولهذا العطر الذي يتضوعُ من النخلةِ والحجر . لن أهتم بالواحة ، سأبتعدُ عنها يوماً ما ، لن أعيشَ عمري كله حارساً أو عاطلاً . سأكتشفُ كنزاً رائعاً ، أو أتحولُ إلى لصٍ من اللصوص . فهل أقدرُ على هذا ؟ وقفتُ ورحتُ أستنشق الهواءَ بملءِ رئتي . سمعتُ ضجة في مكانٍ قصي . إنها قادمة من الشرق ، من جوفِ الغابةِ الكبير . أرهفتُ سمعي جيداً ، إنها ليست قريبة ، غير إني سأمضي إليها . انطلقتُ في دروبً ضيقةٍ متعرجةٍ بين الأشجار . أنوارٌ خفية تتضحُ شيئاً فشيئاً . إنها تقولُ لي : اقتربْ . إنها تدعوني كعاشقةٍ أضنتها الأشواق . الأصواتُ تزدادُ انتشاراً . إنني اقتربُ من الضجةِ غير أني لا أراها . أنا في دائرة الصخبِ لكنني ممنوعٌ من لمسه . إن مجموعة كثيفة من الأشجار تحجبُ صخوراً عملاقة صُفت على شكلِ دائرة . صخورٌ التحمت بعضها بالبعض وكونتْ مسرحاً مذهلاً . إنه مسرحٌ من السحر . إن الضجة تشكلُ غناءً عجيباً يندفعُ من الداخلِ كقصفِ الرعود . إن جوقة تغني كقبيلة وحشية تحي عرساً دموياً . إن النساءَ يصرخن بحدةٍ ويخاطبن سماءً تطلقُ حمماً . بحثتُ عن كوةٍ في الجدار العملاق . رأيتُ الصخورَ متلاحمة بشكل لا يسمح لذبابة بالمرور. لم أيأس . واصلتُ البحثَ . كانت رغبة نارية في أحشائي تدفعني لرؤية عري النساء . رؤية هذه الأجساد الرائعة التي حرمتُ منها عقوداً . وأخيراً وجدت كوة في الجدار . اندفعتُ إليها بكلِ رغبة . لكن ما كدتُ أدخل وجهي حتى امتلأ أنفي وعيني وفمي بالتراب والغبار . رحتُ أعطس بشدة . الغناء ظل يتعالى ويندفعُ كالخيول الوحشية غير مكترثٍ بي . ولم يتوقفْ عطسي إلا عندما ضحكتُ وضحكتُ حتى كدتُ اتقيأ . ابتعدتُ وأنا أنظرُ إلى الخلف وأقول : يا إلهي ، لقد أقاموا دائرة من المتعة واللذة ، وتركوا الحراس وأهل الواحة ، في الخارج ، تحت الريح والمطر .
3
رأيتُ نفسي – فيما يرى النائم – منطلقاً في صحراء لا آخر لها . كنتُ بلا زاد ولا ماء . الأرضُ من تحتي ملتهبة مثل الجمر ، والشمسُ من فوقي تنورٌ هائلٌ يرسل ألسنة من النيران ، والرياح من حولي أعاصير طالعة من جوفِ الجحيم . رحتُ أركضُ وأركضُ بلا هدف . سمعتُ احدهم يتكلمُ بصوتٍ ساخرٍ ، لم أتبين كلماته . حاولتُ أن أعثر عليه فلم أر شيئاً . واصلتُ ركضي بلا توقف . شعرتُ بالأعياء يقطعني قطعة قطعة . عندما وجهتُ بصري صوب الشرق رأيتُ جبلاً شاهقاً يبدو كالعملاق الذي يلمسُ السماءَ بيده . أمدتني رؤيته بطاقةٍ كبيرة ، فواصلتُ الركضَ والغبارُ يملأ وجهي . إن الرجلَ يواصلُ حديثه . إنه يخاطبني بلهجةٍ ساخرة . يسألني : لم العجلة ؟ لا أستطيع أن أجيبهُ فيواصل قوله : لن تجد الكنز . لن تجد الذهب . ستظل طوال عمرك كالعنكبوت العجوز التي لا تصيد شيئاً . لا أهتمُ بكلماتهِ ، ولا اهتم إلا بهذه الريح التي تصفعُ وجهي وهي تضحكُ بهستيريا ، وبهذه الشمس التي أخذت تمدُ أيديها وتشويني . أخيراً ، وكياني كله مفتت ، وقعتُ تحت قدمي الجبل . إنه جبلٌ هائلٌ وله وجهٌ مقطبٌ بشع . كانت على أكتافهِ بعضُ النور التي راحت تحدقُ فيّ بدهشة وحذر . بين قدمي الجبل استقبلني كهفٌ مضيءٌ وباردٌ . كأنه غرفة جميلة أُعدت لي . ولم يكن غرفة بل كان كنزاً مليئاً بسبائك الذهب والأحجار الكريمة . قطعٌ صغيرة تتلألأ بلون البنفسج والورد . معدنٌ نفيسٌ يشعُ بوهج الشمس ودفء الربيع . إنني أسرع إلى ملءِ جيوبي منه . أضعهُ في أكياس وصناديق . أضعهُ بين ثيابي وجسمي . أدفنُ الباقي في التراب . أهيلُ عليه الرمل . أخبئ الأكياسَ والصناديق بين الصخور . إنني أعملُ بعشرات الأيدي . لكن النسور في الأعالي ما تزال تنظرُ إليّ بدهشةٍ وحذرٍ ووجهُ الجبل لا يزال مقطباً وبشعاً .
في رحلةِ العودة تغيرُ كلُ شيء . رحلتْ الشمسُ وحلَّ القمر . سار القمرُ معي وهو يروي لي حكاياته الغريبة مع العشاق . داعبَ الرملُ أقدامي وابتسم لخطواتي المثقلة . اختفت الريحُ الجحيمية وسمعتُ صهيلـَها الوحشي خلف الجبل البعيد . قال القمرُ إنه منذ زمنٍ بعيد لم يقابل عاشقاً خائباً مثلي وأبدى تعجبه الشديد لأنني عشتُ فوق الأربعين دون أن أحب امرأة ما . وحين سألني عن مهنتي السابقة اخبرته إنني كنتُ أصنع الأحلام الرمادية والطائرات الورقية ، غير إنني الآن طلقتُ كلَ ذلك واكتشفتُ طريقي . ذعر القمرُ لا لكلماتي بل للصوص الذين احاطوا بي من كلِ جهةٍ . ظهروا فجأة كالموتِ يقتحمُ مهدَ الطفل . امتدت أيديهم إلى كل جيوبي . انتزعوا القطعَ الذهبية ومزقوا ثيابي . تناثرت الجواهر على الرمل فضحك اللصوص وبانت أسنانهم الكبيرة المشوهة . أضاء القمرُ الدائرة فبان الجميع ، ولما رأيتُ زعيمهم دب الهلعُ في صدري !
4
عاد النورُ إلى القصر وتلاشتْ الموسيقى . حل هدوءٌ رائعٌ في الكون ، لا امرأة تشقُ صدرَها ، ولا آلة تتلوى كأفعى مطلقة فحيحها . أستطيعُ أن أحرسَ بهدوءٍ وأحلم بكنز عظيم . لن يضايقوني بضجتهم الصاخبة . سينامون الآن بعد أن شبعوا من اللذة ، وربما سيوصلونها في غرفهم الدافئة . آه ، إنني أرغبُ في الاستلقاء على فراشي ، أتمنى أن ينبثق الفجر ، وأن تطلع الشمسُ وتكنسُ الظلام . عندئذٍ سوف أعطيهم بندقيتي واندفعُ إلى البيت ، سأجدُ أختي هناك بالتأكيد ، تغسلُ أو تعدُ الشاي أو تثرثر مع امرأة من الجيران . بالطبع لن تكونَ المرأة جميلة ولا حتى مقبولة . اختي اختصت بصداقة العجائز . وهكذا لن أرى امرأة أتفاءل بوجهها المشرق . وهكذا أيضاً ستكررُ أختي سؤالها : متى ستتزوج يا علي ، أيها العجوز الخائب ؟ بالطبع لن أجيبها بشيءٍ . سأتناولُ الأبريق وأصبُ لنفسي بعضَ الشاي ثم أضعُ يدي على المدفأة وأنا أستمعُ إلى حوارهما الذي انقطعَ لبعض الوقت . بعدئذٍ سأخرجُ إلى الواحة . سأحاولُ أن أتخذ لنفسي طريقاً ابتعدُ فيه عن الأولاد . سأحاولُ بكلِ ما أوتيتُ من عقلٍ وخيال أن أخترقَ الحارة كالشبح ، أو كالثائر المتخفي . ومن المؤكد إنني لن أستطيعَ ، ستظهرُ عصابة الأولاد في هذا الزقاق أو ذاك ، ستطلعُ كالسحرة ، كالشياطين . ستنشقُ الأرضُ وتخرجهم ، إنهم يظهرون فرقة تضجُ بالهتافِ والصياح ( علي بابا . . علي بابا . . خبأ الكنز في الخرابة !) . كيف ابتكروا لي هذا الاسم أولادُ الأفاعي ! كيف عرفوا ما بداخلي هؤلاء العفاريت ! لن أقذفهم بالحجارةِ ، ولن أجري خلفهم كالمجنون ، سأمضي وأنا أصرُ على أسناني وألعنُ كلَ أجدادهم !
5
رأيتُ في المنام إنني قطعتُ الصحراء كلها بلا مال أو ذهب . عدتُ فقيراً كما كنتُ طوال عمري ، والأسوأ من ذلك إني أصبحتُ ممزق الثياب ، ذا لحية كثة وأحملُ في بطني معدة فارغة . رأيتُ في الأفقِ نقطة مضيئة ، نقطة تتلألأ بالأنوار ، وتبشرُ بطعامٍ وماءٍ ومرقد . سرتُ وواصلتُ السير حتى طلع الصباحُ ولم تزلْ المدينة بعيدة . . بعيدة كالكنزِ ، كالحبِ ، كالحياة السعيدة . وجاءَ الليلُ مرة أخرى . القمرُ اختفى وذابت حكاياته الغريبة . وبقي الجوعُ مجموعة من الثعابين تعضُ أحشائي بلا توقف . بقيت المدينة بقعة من الضوءِ البهيج يتسللُ إلى الصحراء الميتة ، ولم أتوقفْ ، واصلتُ السيرَ حتى جاء الصباحُ وغدتْ المدينة على مرمى حجر . منيتُ نفسي بقطعةٍ من الخبز وشريحة من اللحم وكأس من النبيذ . سرتُ في شوارعها فرأيتُ المئات من أمثالي ، بحثتُ في القمامة عن كسرة خبز فلم أعثر إلا على نصفِ تفاحة متعفن . أكلته بسرعة وواصلتُ بحثي . سرتُ في الأسواق والحارات ، تسكعتُ قرب المساجد والخمارات ، سألتُ الفقراءَ وتسللتُ إلى بيوتِ الأغنياء ، فلم أجدْ لا الطعامَ ولا المنام ، بل أُشبعُ ضرباً وطرداً . وبينما أنا هكذا إذا بسيارةٍ فارهةٍ تنطلقُ في الشارع كأنها باخرة عظيمة تمخرُ عبابَ البحر . وإذا بي أرى فيها زعيم عصابة اللصوص التي داهمتني في الصحراء وانتزعتْ ذهبي كله . رأيتُ بعضَ الناس ينهض على عجلٍ ويحي الرجل بإجلال وإكبار . ورأيتُ البعضَ الآخر يبصقُ ويطلقُ الشتائمَ في الهواء . لم اهتم بهم ، بل اندفعتُ خلف السيارة كالغريق وجد اليد التي تمتدُ إليه ، أو بالأحرى كالمتهم بجريمةِ قتل وجد القاتلَ الحقيقي يسيرُ أمامه باطمئنان . جريتُ وراء ذلك الهيكل الحديدي ، نسيتُ الجوعَ والآلامَ والأخطار . أحدقُ في السيارة التي أخذتْ تبتعدُ شيئاً فشيئاً . تطلع إليّ الناسُ باستغرابٍ بالغ . قال أحدهم إني مجنون وقال آخر إني ثائر . لم اهتم بهم بل اندفعتُ خلف السيارة ثانية ، اندفعتُ بأقصى ما لدي من قوةٍ وبآخر ما بقي فيّ من نفس . استطعتُ أن ألحق بها ، وجدتها تغيبُ في بناءٍ كبير تحفُ به الأشجار ويلمعُ الذهب . عندما وصلتُ أستقبلني خادمٌ كبيرُ السن . قال لي إن دخولَ الشحاذين إلى القصر ممنوع ، ولكني إذا أردتُ عملاً يستطيعُ أن يوفرهُ لي . قلتُ له إنني صاحبُ حق ، وذاك الرجلُ صاحبُ هذا القصر ، على ما يبدو ، قد سرقَ ذهبي وجواهري . إنه وجماعته اللصوص سرقوا كنزي الذي اكتشفتهُ في الصحراء . الرجلُ العجوزُ لم يأخذْ الموضوعَ مأخذ الجد ، وحذرني بأن أية كلمة جارحة ضد صاحب القصر تعرضني لعقوبة حدها الأدنى عشر سنوات ، فهذا الرجلُ هو الخليفة نفسه !
جلستُ على الترابِ يائساً ، وشعرتُ بجوعي الشديد ثانية ، تأملتُ القبة المذهبة فرأيتها كنصفِ التفاحة المتعفن . ولكنه بعيد أن يُؤكل . قلتُ للرجلِ العجوزِ ثانية : إنني بحاجةٍ إلى عمل . ابتسمَ بخبثٍ ثم أحضر إلي بندقية قديمة تلمعُ كوجههِ المصقولِ جيداً . اعطاني إياها ، فسألته : وما هو عملي يا سيدي ؟ فأشار إلى جماعةٍ من الناس كانت تقتربُ من القصر وهي تصرخُ وتهتفُ . قال لي : أطلقْ عليها . ذعرتُ . نظرتُ إلى وجههِ بخوفٍ وهلعٍ وألم . قال ثانية : أطلقْ عليها . أمسكتُ البندقية جيداً ويداي ترتعشان من الخوفِ والجوع ، نظرتُ إليه فصرخَ بي : أطلقْ ولا تتردد . تطلعتُ إلى الناس . وجدت أطفال الحي يصيحون فيّ (علي بابا . . علي بابا !) ، رأيتُ أختي تصرخُ بي (لم لا تتزوج أيها العجوز النتن ؟) رأيتهم يتقدمون . . فأطلقت . .
6
هدأ القصرُ تماماً ، وحلَّ سكونٌ عميقٌ إلا في الغابةِ التي ظلتْ أشجارُها تتحدثُ بصوتٍ مسموع . وبدأتْ بعضُ الأضواءِ تنطفئ ، فيما بقيت أنوارُ المدينة البعيدة تتلألأ كالأحلامِ السعيدة . اتحه القصرُ إلى فراشهِ كي يعبَ من النوم حتى الضحى ، بينما بقي فراشي بعيداً ، وفجري الرائع لم تظهر بشائرهُ بعد .
سأظلُ هنا في البردِ القارس حتى تظهر محبوبتي الجميلة : الشمسُ ، وعندئذٍ سوف أسلمهم بندقيتي وأنطلقُ إلى الواحة . سوف أسرعُ إلى الأخت لسماعِ ثرثرتها المحببة . ولكن هل ستجد الواحة ؟
يا لفظاعةِ هذا السؤال ! أجل ، قد انطلق إلى الواحة فأجدها قد احترقت ، في ذلك الصباح الخانق من أيام الصيف ، حينما توجهتُ إلى حارتنا القديمة رأيتُ سحابة عظيمة من الدخان كالشيطان الشرير يحومُ فوق سمائنا . لقد سرتْ فيّ خواطرُ سوداء وارتعدتْ فرائصي ، وسرتُ وأنا لا أرى شيئاً سوى هذا الدخان الملعون . سرتُ بسرعة لم أشعر بجسمي الذي تفتت ، وأصابعي التي تمزقت ، كنتُ أحاولُ أن أصلَ مهما كان الثمن ، علني انقذ بقية حاجياتي وأموالي . لقد تذكرتُ ذهب أختي القليل الذي جمعتهُ من الغسل والطحن والطبخ فهل سيذهب هو الآخر إلى الضياع ؟ أركضُ بأقصى ما لدي من سرعةٍ وقوةٍ ويظلُ الحي يلوحُ أمامي ويبتعد عني . إنني لا أسمع أبواق سيارات الإطفاء أو الإسعاف ، إن الحيَّ كله عبارة عن سحابة من الدخان والنيران . إنه يموجُ بكتلِ البشر الذي يحملون الأغراضَ أو يحاولون إطفاء النار أو مساعدة النساء والمصابين . ذهلتُ من الصراخ والبكاء وفحيح النيران وأصوات الأشياء التي تنفجر . شققتُ طريقاً وسط الفوضى والخراب . كنتُ أتلهفُ لرؤية منزلنا ولرؤية أختي . ورغم إنه يقعُ في قلب العاصفة إلا أنني شعرتُ بأملٍ غامضٍ في أن أراه وقد انقذته السماءُ من الموت . ولم أنتبه إلا وأنا أمام المنزل ، أو أمام كومةٍ كبيرةٍ من الرماد والأحجار السوداء التي يتصاعدُ منها الدخانُ والوهجُ ورائحةُ الأرضِ المشوية والأشياء المحترقة .
إنه طعمٌ خاصٌ ومذاقٌ غريبٌ للنار وللبيتِ الذي تلاشى فجأة . تذكرتُ أختي . تركتُ كلَ شيءٍ وبحثتُ عنها . بين كومةٍ كبيرةٍ من بقايا المنزل وجدتها . كانت تضعُ يدَها تحت خدها وتبكي . رأيتها وهي ذاهلة محمرة العينين صفراء الوجه . ولما تنبهت إليَّ ضجتْ بالبكاء والصياح (أموالك يا أخي . . ذهبي . . ضاع كله ! !) .
7
صمتتْ كلُ الأشياءِ في المكان ، حتى الشجر توقف برهة طويلة عن الكلام . غرق القصرُ في النوم ، وماتت أضواءُ المدينة البعيدة ، واقفرت الطرقات . ولم يبقَ ساهراً سوى نجمة أو نجمتين . . وبقيتُ وحدي في هذا المكان يقظاً وبردان وشاهراً سلاحي . بعد قليل قد يبزغُ الفجرُ وربما يمتدُ الليل طويلاً . في الصباح أكونُ قد انهيت واجبي ، وأسرعتُ متوجهاً إلى الواحة . لا أظنُ أنها ستحترق ، ستبقى وسوف تصبح شيئاً آخر ، أروع وأجمل . سأتجهُ إليها ثم أتغلغلُ في طرقٍ ملتوية متجنباً الأطفال . ستبقى واحتنا . . وأنا سوف أتزوج وأنجب أطفالاً أشقياء يتربصون بمن يمر ويكشفون أحلامه . ستبقى . . أفٍ ألا تنتهي أيها الليل الطويل ؟ لكن ما هذا ؟ لقد غفلتُ عن هذه الأشياء الخطيرة . . إنهم آلاف من الأشخاص يزحفون نحو القصر . آلاف المشاعل تضيءُ هنا وهناك وكأنها أعلامٌ دامية . زحفٌ صامتٌ منظمٌ يهددني بالموت ويهدد القصر بالسلب والحرق . من أين طلع هذا الجيش المخيف ؟ لا شك إنهم أعداء أقوياء تسللوا إلى مملكتنا . يا رب ، ماذا أفعل ؟ ما الذي تستطيعُ هذه البندقية أن تقومَ به أمام هذا البحر الزاخر من النيران والبشر ؟ إنهم يقتربون شيئاً فشيئاً . مدٌ ينمو قليلاً قليلاً . عما قريب سيجتاح الطوفانُ كلَ شيءٍ . إنهم ينهضون ، يندفعون كتلاً متراصة نحو القصر ، يهتفون ويصرخون . ماذا يريدُ هؤلاء الأعداء ؟ إن الأضواءَ التي أشعلوها تفضحهم جيداً . ولكن أليس هؤلاء هم سكان الواحة ذاتها ؟ كيف تجمعوا هكذا وتحولوا إلى غضبٍ جامح . لو كنتُ حتى وحدي سأطلقُ النار . سأرفعُ بندقيتي وأصوب جيداً . لا يهمني أحداً منهم . إنهم يقتربون ويقتربون . وجوههم أعرفها ، حتى الأطفال بينهم . وهذه أختي أيضاً . البندقية تهتزُ في يدي . لا أعرفُ كيف أطلقُ النار . النار ! حريقٌ آخر . . . ! البندقية تهوى من يدي . لكن البشر يتلاشون ، والأضواءُ تختفي ، والضجيجُ يذوبُ في السكون . لا أحدَ هناك مطلقاً . والصمتُ يخيم على كل شيء . إن أحلامي لا تنتهي ، ولن ارتاح إلا عندما ينهضُ الفجر . فمتى ينتهي هذا الليلُ الطويلُ ؟ متى يبزغُ الفجرُ الرائع ؟ إنه بعيد . . بعيد . وعلي أن أظل هنا منتهباً يقظاً ، فقد يأتي جيشٌ مرعبٌ حقيقي . قد يطلع سكانُ واحة الأزهار هنا كالدمار ، عليّ أن أراقب مجيئهم المخيف ، وأمسك بندقيتي جيداً . أتطلع إلى القصر ، إلى القبة المذهبة ، الغرف ، الردهات ، القاعات ، الغابة ، أتطلعُ إليها ورعشة غريبة تسري في بدني كله وشفتاي تتمتمان : متى ينتهي هذا الليل الطويل ؟
August 30, 2023
محمد باقر الصدر
في كتابه (فلسفتنا) يعتبر محمد باقر الصدر المفكر الديني الراحل وجهة نظره بأنها (مجموعة مفاهيم الإسلام عن العالم) ، ويعتقد بأن ثمة صراعاً فكرياً مريراً (لا بد للإسلام أن يقول كلمته) فيه ص 6 ، فيتصور بأن ما يقوله هو المعبر عن الإسلام لا وجهة نظر شخصية أو وجهة نظر تيار أو مذهب .
وهو من البداية يؤكد (صحة الطريق العقلية في التفكير ، وإن العقل ، بما يملك من معارف ضرورية فوق التجربة ، هو المقياس الأول في التفكير البشري ، ولا يمكن أن توجد فكرة فلسفية . أو علمية دون إخضاعها لهذا المقياس العام ، وحتى التجربة التي يزعم التجريبيون أنها المقياس الأول ، ليست في الحقيقة إلا أداة لتطبيق المقياس العقلي ، ولا غنى للنظرية التجريبية عن المنطق العقلي.): (فلسفتنا ، محمد باقر الصدر ، دار التعارف للمطبوعات ، 1979 ، ص 7 ، بيروت).
فهو يعتبر (العقل) هو المهيمن على التجربة وعلى الفكر التجريبي ، وهذا العقل غير موضح الفصيلة في بداية كتابه السابق الذكر.
ولكي يمهد محمد باقر الصدر لمناقشة وتفنيد الماركسية ، باعتبارها الخصم الرئيسي للفكر الديني كما يتصور ، فإنه يناقش طبيعة الأنظمة السائدة في زمنه وهي :
1 – النظام الديمقراطي الرأسمالي .
2 – النظام الاشتراكي .
3 – النظام الشيوعي.
4 – النظام الإسلامي .
وهو يعتبرُ بأن مشكلة الإنسان عميقة الجذور لكننا لديه لا نعرف مسيرة العلاقات الإنسانية إلا بشكل ضبابي أخلاقي مجرد ، يقول :
(فإن هذه العلاقات التي تكونت تحقيقاً لمتطلبات الفطرة والطبيعة في حاجة بطبيعة الحال إلى توجيه وتنظيم ، وعلى مدى انسجام هذا التنظيم مع الواقع الإنساني ومصالحه يتوقف استقرار المجتمع وسعادته)، (ص 11).
وهكذا تتشكل لديه الإنسانية عبر الفطرة والطبيعة وبالتالي فإن تاريخاً غائراً عميقاً يتوارى هنا ، وتظهر الإنسانيةُ المعاصرة كمذاهبَ فكريةٍ فلسفيةٍ سياسية ، مقطوعةِ السياقِ عن سيرورةِ التاريخ والطبقات ، وبالتالي فإنه لا يقوم بأي ربطٍ بين المذاهب والقوى الاجتماعية ، محولاً المذاهب إلى كينوناتٍ متجوهرةٍ على أنفسها منذ البداية ، ويعتبر النظامان السائدان في العالم في زمنه هما (النظام الديمقراطي الرأسمالي هو أساس الحكم في بقعة كبيرة من الأرض ، والنظام الاشتراكي هو السائد في بقعة كبيرة أخرى)، (وأما النظام الشيوعي والإسلامي فوجودهما بالفعل فكري خالص).
عبر قطع الأنظمة والأفكار عن سياقاتها الكبرى يقوم بعد ذلك باختيارِ جانبٍ رئيسي من النظام ليعتبره هو النظام الكلي ، فيقول عن النظام الرأسمالي بأنه قائم على (الإيمان بالفرد إيماناً لا حد له . وبأن مصالحه الخاصة بنفسها تكفل – بصورة طبيعية – مصلحة المجتمع في مختلف الميادين) ويعلقُ محمد باقر على هذا النظام من الوجهة الفكرية قائلاً: (ومن الواضح إن هذا النظام الاجتماعي نظام مادي خالص ، أُخذ فيه الإنسانُ منفصلاً عن مبدئه ، وآخرته ، محدوداً بالجانب النفعي من حياته المادية ، وأُفترض على هذا الشكل . ولكن هذا النظام في نفس الوقت الذي كان مشبعاً بالروح المادية الطاغية … لم يُبن على فلسفة مادية للحياة وعلى دراسةٍ مفصلةٍ لها) ، ولكن هذا لا يعني بأن الباحث محمد الباقر لا يعتبر النظام الرأسمالي صاحب ثقافة مادية (فلسفية هنا) ، ( بل كان فيه إقبال على النزعة المادية : تأثراً بالعقلية التجريبية التي شاعت منذ بداية الانقلاب الصناعي وبروح الشك والتبلبلِ الفكري الذي أحدثه انقلابُ الرأي ، في طائفةٍ من الأفكار كانت تعدُ من أوضح الحقائق وأكثرها صحة وبروح التمرد والسخط على الدين المزعوم ، الذي كان يجمدُ الأفكارَ والعقولَ ، ويتملقُ الظلمَ والجبروتَ) ، (ص 17 ـ 18) . نحن نرى هنا إن عشرة قرون من التطور العلمي و الثقافي والروحي الأوربي تــُركز في مظاهرٍ مختزلة ، فهناك تمردٌ وسخط وهناك شك وبلبلة وهناك فلسفة تجريبية ، لكن يبدو إن ليس هنا ثمة بناءٌ فكريٌ وأخلاقي كما يتصور الباحث ، فقد دمر الغربيون الدينَ المزعوم ، لكنهم لم يشكلوا وعياً دينياً آخر حسب تصوره ، أو أنهم بلا مظاهر روحية وثقافية غنية وعظيمة ، وهذا الاختزالُ الذي يقومُ به الباحثُ بإلغاء الدين المعاد تجديده أو فصله عن الدولة الغربية ، يغدو لديه إبعاداً كلياً للدين عن المجتمع وعن الثقافة ، وهي الأمور التي لم تجرِ في الغرب ، كما أن ثقافة أخرى غير دينية وأخلاقية كذلك لم تتشكل مهيمنةً على كل الفضاء الروحي ، وهو بعد هذا الإلغاء لثقافة روحية أخلاقية وهامة في الغرب يستنتج :
(كل هذا صحيح ، ولكن النظام الرأسمالي لم يركز على فهم فلسفي مادي للحياة ، وهذا هو التناقض والعجز ، فإن المسألة الاجتماعية للحياة تتصل بواقع الحياة ، ولا تتبلور في شكل صحيح إلا إذا أقيمت على قاعدة مركزية ، تشرحُ الحياةَ وواقعها وحدودها ، والنظام الرأسمالي يفقد هذه القاعدة)، (ص 19) .
وهذه التعابير الغامضة يُـقصد منها عدم وجود أساس ديني للنظام الرأسمالي الغربي العلماني ، فبدون وجود رجال دين يهيمنون على النظام فإنه يخضع لزوال الأخلاق: (والدليل على مدى اتصالها بالحياة من الديمقراطية الرأسمالية نفسها أن الفكرة تقدم على أساس الإيمان بعدم وجود شخصية أو مجموعة من الأفراد ، بلغت من العصمة في قصدها وميلها وفي رأيها واجتهادها ، إلى الدرجة التي تبيح إيكال المسألة الاجتماعية إليها ، والتعويل في إقامة حياة صالحة للأمة عليها)، (ص 19ـ 20).
إن الثقافة الروحية والفكرية الأخلاقية تــُفهم من قبل السيد محمد باقر بأنها إيكال أمر السيادة السياسية إلى رجال الدين وبدون ذلك فإنه لا توجد حياة صالحة للأمة ، وهذا يعني ضرورة هيمنة رجال الدين على المؤسسات السياسية لكي يكون هناك تطور روحي وأخلاقي في المجتمع !
ومن هنا فإن (القيم المادية؛ بمعنى الابتذال السوقي هنا) هي التي تسودُ في الحياة الديمقراطية الرأسمالية حسب رأيه. ولهذا قام الباحثُ بإزالة التطور الفكري والأخلاقي الطويل من نسيج الحضارة الغربية خلال القرون العشرة الأخيرة ، وغيّب مختلفَ أشكال الثورة الثقافية والفكرية والفلسفية الغربية التي تفجرت كثقافة النهضة ثم التنوير ثم ثقافة العصر الصناعي والثورة الديمقراطية البرجوازية ثم صعود ثقافة الطبقات العاملة ، وذلك فقط بسبب إبعاد الدين عن السلطة السياسية ، في حين أن الدين المسيحي مع غيره من الأديان لا يزال يقوم بالسيادة العبادية على الحياة الاجتماعية في الغرب خلال هذه القرون كلها .
أي أن الغرب (العلماني) لم يحطم الهيمنة الدينية المسيحية على الناس ، حيث قامت القوى المهيمنة بنشر والحفاظ على الدين في الوعي الجماهيري بمختلف الأشكال ، مثلما يوجد وعي لا ديني غير أنه غير مهيمن ، ولهذا فإن موضوع سيادة الدين على الحكم هو الذي يجعل الحياة مادية غير روحية في تصور السيد محمد باقر!
(وكان من جراء هذه المادية التي زخر النظامُ بروحها أن أُقصيت الأخلاق من الحساب ، ولم يلحظ لها وجود في ذلك النظام .. وأعلنت المصلحة الشخصية كهدف أعلى .. فنشأ عن ذلك ما ضج به العالم الحديث من محن وكوارث..)، (ص 20) .
إن العالم الصالح في نظر الباحث هو الذي يتمكن رجالُ الدين من إدارته حيث تغدو الأخلاق في بؤرة الاهتمام ، فالعالم الرأسمالي الذي لم يسيطر عليه الروحانيون غدا بلا أخلاق ، وصار التكالب على الماديات ، وهنا يجري في وعي محمد الباقر تغييب الصراعات الاجتماعية التي شكلت مسار التطور ، وكذلك نمو المستويات الثقافية والأخلاقية الغربية عبر هذا الصراع الاجتماعي نفسه ، فالتكالب على الماديات يعتبره سبب الكوارث ، في حين أن النظام الغربي يجعل الصراع على (الماديات) كالأرباح والأجور والخدمات الخ .. جوهر نشاطه السياسي الرسمي والشعبي ، في حين أن الجانب الروحي والاجتماعي مباح للدين وغير الدين ! ففصل الدين يجري فقط في إدارة المجتمع السياسية أما غير ذلك فإن للدين دوره الكبير ، ولهذا فإنه حتى الأخلاق الدينية لها مكانتها!
ويتصور الباحث محمد باقر إنه عبر هذه الحياة المادية الاستهلاكية (لا توجد قيم) وتتحكم (الأكثرية في الأقلية ومسائلها الحيوية) ص 21 ، وهو يقصد هنا تحكم الجمهور المادي في الجمهور الروحي الديني ، (وما دامت الأكثرية لا تعرف للقيم الروحية والمعنوية مفهوماً في عقليتها الاجتماعية ؟؟) ص 22 ، أي أن إبعاد رجال الدين عن السيطرة الفكرية على الجمهور الذي لا يعرف القيم الروحية هو أمر يؤدي إلى حيونة الإنسان .
والباحث محمد باقر هنا يعود إلى الخلفية الشرقية وإلى قيام بعض اتجاهات الدين الكفاحية دورها التحويلي والأخلاقي ، وهو يتصور بأنه مع غياب ذلك لا يعود الغرب سوى غابة !
إن تحويل الجمهور الغربي بأغلبيته إلى قطيع حيواني ، هو مسألة لا علاقة لها بالتطور الحقيقي ، ولكنه هنا يتشكل في وعي السيد محمد باقر مثلما يتشكل في وعي بعض عامة المسلمين عبر تعميم بعض المظاهر و عزلها عن اللوحة العامة وتضخيم هذه المظاهر بشكل كاريكاتيري ، في حين أن التطور الأخلاقي والثقافي الرفيع يجري في الغرب بمواكبة النضال ضد مظاهر ابتذال الإنسان واستغلاله . فالنضال من أجل تطور حياة الإنسان المادية لا ينفصل عن النضال لتطور حياته الأخلاقية .
إن هذا الإسقاط الديني الإيديولوجي للسيد محمد باقر جرى في أزمنة لم تكن الرؤية الشرقية للغرب متعددة وعميقة وذات مستويات مختلفة ، كذلك فإن الإسقاط يجري من مواقع الفئات الوسطى والصغيرة الإسلامية التي ترفض هيمنة الشركات الكبرى الغربية في الغرب والشرق كذلك ، وهو ما يؤدي إلى دهس إنتاجها المادي والثقافي . وهو أمر يشعر المتصدون للقيادة الدينية والسياسية بخطورته على العالم .
إن محمد الباقر يفسر الأسلوب الرأسمالي للإنتاج بشكل فكري أخلاقي ، (كل هذه المآسي المروعة لم تنشأ من الملكية الخاصة ، وإنما هي وليدة المصلحة المادية الشخصية التي جعلت مقياساً للحياة في النظام الرأسمالي ، والمبرر المطلق لجميع التصرفات والمعاملات)، (ص 35).
فالملكية الخاصة لم تنتج ثقافتها المختلفة عبر العصور ، بل لعبت روحيةُ المصلحة الشخصية الأنانية هذا الدور الاستغلالي ، وحين تــُضاف القيم النبيلة إلى الملكية الخاصة فإنها تنتج أدواراً اجتماعية مختلفة في رأيه ، ومن هنا كان يمكن للنظام الرأسمالي الغربي أن يكون شيئاً آخر لو كان هناك رجال دين مختلفين غير استغلاليين وفاسدين ، حيث يمكن لرجال الدين النزيهين المتحكمين في جهاز الحكم أن يصنعوا غرباً مختلفاً !
وهنا يفكر محمد باقر كذلك من خلال تاريخه الاجتماعي الشرقي ، حيث الملكية الفردية الإنتاجية في الحقل والحرف والملكيات الصغيرة تتوازى مع ملكية الدولة ، وحيث لا تزال العلاقات الاجتماعية لم تترسمل بشكل واسع ، كما أن هذا الوعي يعبر عن حياة الركود طوال عصور حيث لعبت الدولُ المركزية عبر الأديان والمذاهب دور المهيمن ، فهنا اندمج الدور (الأخلاقي) للملكية الخاصة مع الدور الحكومي ودور رجال الدين ، وحيث أُعتبرت الملكية الخاصة خالدة لا يسبقها تاريخٌ مشاعي طويل ، وبالتالي فإن محمد باقر يريد أن يشرقن ويمسلم الغرب ، الذي غادر التاريخ الشرقي حيث الترابط بين الملكية الخاصة الصغيرة والإدارة الحكومية وسيطرة الأديان والمذاهب ، وقد جعل الغربُ قوى الإنتاج في ثورة مستمرة مرتبطة بالسوق المحلية والعالمية ، فهي تعيدُ تشكيلَ البنى الاجتماعية والفكرية بشكل دائب ، لكي تسهمُ في عملية التغيير الاقتصادية التي يتحكم فيها الرأسماليون وعبر صراع دائب مع العمال .
ولهذا فإن السيد محمد باقر يرى التجربة المسماة (اشتراكية) بنفس الرؤية ، فيقرأها بالصورة التالية: (أما مضاعفات هذا الإنتاج فهي جسيمة جداً : فإن من شأنه القضاء على حريات الأفراد ، لإقامة الملكية الشيوعية مقام الملكيات الخاصة . وذلك لأن هذا التحويل الاجتماعي الهائل على خلاف الطبيعة الإنسانية العامة)، (باعتبار إن الإنسان المادي لا يزال يفكر تفكيراً ذاتياً ، ويحسب مصالحه من منظاره الفردي المحدود) وهذا كله جعل الاشتراكيون يشكلون (قوة حازمة تمسك زمام المجتمع بيد حديدية ، وتحبس كل صوت يعلو فيه ، وتخنق كل نفس يتردد في أوساطه ، وتحتكر جميع وسائل الدعاية والنشر..)، (ص32).
يعتبر محمد باقر كما تقول (الماركسية – اللينينة) بأن التجربة التي جرت في الاتحاد السوفيتي والصين وغيرهما بأنها تجربة (اشتراكية) ، وليست رأسمالية دولة شمولية ، وهو لا يؤيد هذا البناء من ذات منطلق الملكية الخاصة الصغيرة التي ستُحطم هنا من خلال الدولة وليس من خلال الرأسماليين كما في الغرب ، ولكن بمضاعفات أخرى وهي غياب الحرية الفردية كذلك ، وهو يجعل هيمنة الملكية الخاصة جزءً من (الطبيعة الإنسانية) ، كما أنه يتنبأ بشكل صحيح بعودة (الاشتراكية) إلى الرأسمالية العادية لأن المديرين والمهيمنين على المال العام هم أفراد ، أي كما لاحظ تروتسكي بأن البيروقراطية تنخر (الاشتراكية) المفترضة كما تنخر التجارب التنموية الرأسمالية الفردية في العالم الثالث الأخرى .
لكن منطلقات محمد باقر دينية مثالية ، حيث تتناغم لديه الملكيةُ الخاصة الصغيرة والدينُ والدولةُ المسيطرة الشاملة في علاقة شرقية أبدية . دون أن يقرأ بأن رأسمالية الدولة الشرقية (الاشتراكية) جرت بسبب عوامل نهضوية تسريعية ، وبهذا فإن المركزة الاقتصادية الحكومية أدت إلى تجاوز هذه البلدان منظومة الدول المتخلفة ، وأجرت ثورة ثقافية وتقنية ، بسبب عدم جعل الملكية الخاصة الصغيرة والمذاهب تتحكم في البناء الاقتصادي العام ، ولكن كان لذلك ثمن باهظ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
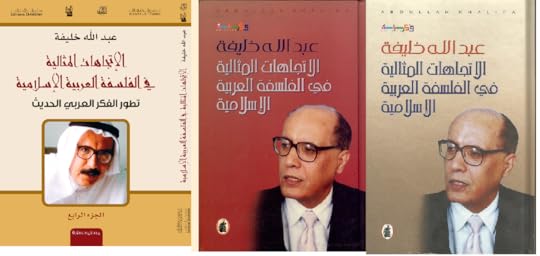
انظر عبـــــــدالله خلــــــــيفة: الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية ، الجزء الرابع ، تطور الفكر العربي الحديث , وهو يتناول تكون الفلسفة العربية الحديثة في مصر خاصة والبلدان العربية عامة، منذ الإمام محمد عبده وبقية النهضويين والمجددين ووقوفاً عند زكي نجيب محمود ويوسف كرم وغيرهما من منتجي الخطابات الفلسفية العربية المعاصرة ، 2015.
انتقائية حسن حنفي
يبدأ حسن حنفي مشروعه الفكري برفض الفكر الديني التقليدي شكلاً ، ويقوم بنقد طريقة القدامى في البناء النصوصي لمؤلفاتهم ، فيقول :
(في هذه المقدمات الإيمانية تتحددُ علاقة الإنسان بأنه فقط ليس فقط على مستوى المعرفة والنظر بل أيضاً على مستوى السلوك والعمل ، فالإنسان يحمد الله على نعمه ويشكره ، على فضله ، مما يجعل العلاقة أحادية الطرف ، من واهب (إلى) موهوب ، ومن معطى إلى معط إلى ، وتجعل الإنسان مجرد وعاء للنعم ، ومستقبل للعطايا (…) وإن كثيراً من مآسي عصرنا لهو انتظار الكرم والجود ، والتشوق إلى الهدايا والعطايا ، والتزلف من أجل هبات السلطان حتى أصبح العصر كله عصر تعايش وارتزاق . .)، (1).
إن أي فقرة لدى حسن حنفي تعطينا طريقة التفكير ، حيث يجري الدخول إلى عصر ما واقتطاع فكرة أو عبارة ، ثم رؤيتها بطريقةٍ ذاتية ، أي من خلال وعي الكاتب المنفصل عن البنية الاجتماعية ، ثم الحكم عليها عبر ذلك الشعور ، ومن ثم الانطلاق بها إلى عصر آخر مغايرٍ وذي حيثيات مختلفة ، وإسقاط المعنى المستلِ على العصر الجديد المختلف .
فطريقة المؤلفين العرب والمسلمين في الثناء على الله وحمد رسوله والسلف الصالح الخ . . ذات نسق مرتبط بعصر تكرست فيه مثل هذه اللغة والمعاني الدينية التي هي مقدمة لأي بحث ، سواء لدى جماعة أهل الحكم أو جماعة المعارضة لأهل الحكم ، وهذه الطريقة التأليفية قام المؤلفون العرب والمسلمون بتجاوزها في زمن النهضة بدءً من القرن التاسع عشر لكن حسن حنفي يعيدنا إليها ، موجعاً القارئ بالهجوم على طريقةٍ غدت في ذمة التاريخ ، لكن الكتاب ليس بحثاً في طرق تأليف الكتب ومقدماتها ولا يعتبر طرق التأليف كبؤرة لمؤلفه بل هو يريد أن يناقش التراث والعصر.
ولهذا نجد الفقرة تقفز من نقد طريقة المؤلفين القدامى ولا تقوم بدرس أسباب هذا الإنشاء إلى أن تعمم قائلة إن هذه الطريقة هي باب للكثير من المشكلات ، (وإن كثيراً من معاني عصرنا لهو انتظار الكرم والجود).
فهو يقفز من قضية طرق التأليف القديمة قبل عشرة قرون إلى الزمن الحالي مصوراً بأن طريقة المؤلفين القدامى في الثناء على الله هي من أسباب النفاق المعاصر!
إنه استلالٌ لعنصر تراثي من بين شبكته الواسعة وتعليقه في فضاء لاتاريخي مجرد ، ثم سحبه إلى بُنى اجتماعية أخرى لها سيرورات مختلفة وقوانين متغيرة ، عبر شحنٍ عاطفي وتدفق لغوي.
إن المؤلفين القدامى حين يحمدون الله على طريقتهم فلا يعني هذا بأنها طريقة لتكريس السلبي ومدح السلاطين ، فهي طريقة تقليدية يقوم بها المنتمي للسلطة والمعارض لها ، وهي جزءٌ من بناءٍ ديني ثقافي خاص بالعصر السابق ، لكن طريقة المؤلف تقوم على الاستفزاز والنفخ العاطفي والاستعراض .
وثمة جمل في هذه المقدمة التي تقدم المشروع الفكري لحسن حنفي تنسف المشروع كله مثل هذه العبارة :
(كانت تجارب القدماء في أغلبها صوفية وفي أقلها علمية نظرية ، وبالتالي خلت من أي مضمون اجتماعي ، وكيف يهتز العالم كله من مجرد تجربة ذوقية شخصية تعتلجُ في صدر صاحبها ، ويموج بها قلبه ، ويهتز لها وجدانه ؟ ..(. .) انما تجاربنا نحن فهي اجتماعية بالأصالة ، تجارب ذات مضمون ، وضعناها في التراث . .) ،(2).
تعطينا هذه العبارة تعميماً عن الصوفية والنتاج الثقافي بنسبة غير دقيقة ، ثم أن وجود نتاج بلا مضمون اجتماعي ، هو كلام غير علمي . ثم يقوم بسحب الصوفية إلى عصرنا ويجري التدفق اللغوي العاطفي والمليء بالاستطرادات التي تحاول النفخ في تلك الفكرة.
إن العبارة هنا تكرس تناقضات مطلقة غير جدلية : صوفية بلا مضمون ، صوفية معاصرة ذات مضمون ، فكر غير اجتماعي ، فكر اجتماعي .
سوف نجد إن هذه الطريقة التعبيرية – الفكرية هي منهج المؤلف ، فهو وعي يعيش التضادات المطلقة ولا يستطيع أن يجمع بينها ويدرسها بشكل جدلي .
يقوم بعد ذلك بدرس التراث الإسلامي بمناقشة مصطلحاتها كمصطلح (علم الكلام). لنأخذ عبارة من حديثه عن نشأة علم الكلام هذا:
(أما السؤال الذي من أجله تطايرت الرقاب وقضى على الحريات ، وقاسى المفكرون بسببه أشنع أنواع الاضطهاد وهو : هل الكلام قديم أم محدث؟ فإنه ينطبق على سائر الصفات)، (كما وصل الخلاف إلى حد القتال وشق الأمة إلى فرق متنازعة متحاربة في موضوع الإمامة ، آخر موضوع في السمعيات)،(3).
يقومُ المؤلفُ هنا بالقفز على نمو علم الكلام ، حيث استغرق الأمر في ذلك قرناً كاملاً نمت هذه المسألةُ من بذورٍ صغيرة حتى غدت بؤرةً للصراع الفكري والسياسي ، ففي البداية لم يكن هناك شق(للأمة) ، ثم مع تفاقم الصراع الاجتماعي فإن الطبقات والأمم الإسلامية راحت تعبرُ عن نفسها من خلال المقولات الدينية المختلفة ، وهنا نجدُ في طريقة حسن حنفي عدم القدرة على بحث المسألة بتأنٍ ورؤيتها وهي تتداخل مع العناصر الأخرى ، فهو سرعان ما يقفز إلى النتائج بدون تحليل بنيوي،(4).
أي أنه لا يقوم بتتبع المسائل النظرية وهي تتشكلُ في بناها الاجتماعية ، فنجد تعبير (وصل الخلاف إلى حد القتال وشق الأمة) وهي تعبيرات تختزل التاريخ المعقد الطويل وتجوهر الأمم الإسلامية في تعبير (الأمة) وكأن الصراعات لم تبدأ منذ البداية وذات مخاض اجتماعي قبلي – قومي – طبقي ، ولكن هذا لا يحدث في بناء حسن حنفي لأنه لم يقم بوضع مقدمات لمثل هذا الدرس ، فهو يقفز فوراً إلى علم الكلام ، ثم إلى صراعات الأمة المقدسة بلا تمهيد تاريخي وبلا درس اجتماعي .
يقدم لنا حسن حنفي بعد ذلك النتائج التالية عن علم كلام:
(الكلام الأول (كلام الله) لا يمكن معرفته معرفة مباشرة إلا من خلال الكلام الثاني (القرآن).
(وفي هذه الحالة يمكن للكلام باعتباره الوحي الموجود أمامنا . .). ( يمكن لهذا الكلام أن يكون موضوعاً للعلم بل لعدة علوم . .)، ص 59.
إن المؤلف هنا يدخلنا في علم الكلام وهو مقطوع الجذور ، ثم يستنتج بأنه خلاف حول علم الله والقرآن وأن الأول لا نعرفه والثاني هو تجسيد للأول ، وكل هذا اقتطاع لسيرورة التاريخ أي لعمليات درس المصطلحات : الله ، الإله الواحد ، اللغة الإلهية وتاريخها ، القرآن ، الفرق ، تأويلات القرآن عند الفرق الخ . .
إن مسألة علم الكلام تــُطرح وهي مقطوعة السياقات ، ولا يتم بحثها كتطورٍ فكري طويل متداخل مع الصراعات الاجتماعية بل كجوهر نصوصي بلا سياق تاريخي ، وإذا جرت الإشارة للخارج فهي إشارة طيفية ، فالداخل أو المبنى الفكري ، أي علم الكلام هنا ، يجري تطوره من داخله وليس باعتباره جزءً من كل هو البنية الاجتماعية التي ينمو داخلها .
ثم يستنتج علوماً ينبغي أن تدرس علم الكلام ومنها علم السياسة:
(ويمكن لعلم السياسة البحث عن نشأة علم الكلام في ظروف سياسية خاصة ، واستعمال الوحي لإفراز أما تراث السلطة أو تراث للمعارضة كما هو واضح في أدبيات الفرق ، ومدى استمرار ذلك حتى الآن في علاقة السلطة بالمعارضة واعتماد كل منهما ، خاصة السلطة على الموروث العقائدي القديم)، ص60.
ونستغرب لماذا لم يقم الباحث بقراءة ذلك وهو موجود حتى في المراجع الفكرية المعاصرة ككتب أحمد أمين وحسين مروة ومحمود إسماعيل وبالتالي أن يقوم بالدرس السياسي لعلم الكلام؟
فمثل هذا الدرس سيجعله يقرأُ علمَ الكلام بصورة عميقة كلية وليس بطريقة تفتيتية تزيح دلالاته العامة ، ولهذا فهو يعتذر للقارئ عن عدم قيامه بهذا الدرس الاجتماعي والسياسي فيقول في الهامش (تقـتصر مهمة التراث والتجديد على وضع (علم الكلام) داخل (تاريخ الأفكار) . أما وضع (تاريخ الأفكار) في (التاريخ الاجتماعي) وتطبيق كل نتائج ونظريات ومناهج (علم اجتماع المعرفة) فتلك مهمة مجموعة من الباحثين تضم المفكرين وعلماء الاجتماع معاً ، وينؤُ بها باحثٌ واحد . فهذا ميدان للبحث وليس موضوعاً للبحث ، وقد بدأ كثيرون في المساهمة في ذلك فيه مثل د . محمود إسماعيل (سوسيولوجيا الفكر الإسلامي، جزءان . .)، ص 61. (سوسيولوجيا الفكر الإسلام من أربعة أجزاء، ملاحظة مني ع. خ).
والواقع إن الحجة هنا شكلية فهذا المؤلف الضخم الذي يدخل تفاصيل علم الكلام والفلسفة والمذاهب المختلفة كيف يعجز عن رؤية الأبعاد الاجتماعية التي يتشكلُ داخلها علمُ الكلام وغيره؟!
إن المسألةَ إذن ليست مهمةً ينؤ عنها باحثٌ بمفرده بل مسألة منهج ، ولكن المؤلف يعرض ذلك السبب العرضي لأنه سيستفيد في بعض الفقرات من المنهج الاجتماعي في قراءة التراث ، ولكن بشكلٍ وامض وبلا قيمة فكرية .
إن استخدام هذا المنهج بشكل عرضي والإيمان الغائر به داخلياً وغير المتبلور نظرياً هو صلب الإشكاليات الكبرى التي يعاني منها المبنى الفكري لحسن حنفي .
إذن هناك منهج آخر لم يصرح به المؤلف وعلينا أن نقرأ هذه المبنى وكيف تجسد في حيثيات الدراسة المختلفة .
ولنلاحظ كلمة (الوحي) في العبارات السابقة فهي مفتاح فهم هذا العالم ، فالوحي وصورة الإله التي تخلقه هما شيئان تجريديان مضيئان متجوهران في هذا النقاء الغيبي ، وهما منطلقا المشروع وأساسه لكن الباحث لا يقول لنا لماذا هذا النقاء التجريدي والتجوهر؟
أي أن حسن حنفي لا يقول لنا بأن هذا العنصر المثالي ، أي الفكري التجريدي هو الذي يخلق المادة ، فهو لا يوضح مصدر فلسفته وانتماءها وهل هي مادية أم مثالية ؟ لكن طريقة الطرح المتوارية التي تأتي في فيض لغوي هي جزء من المنهج الحربائي الذي يستخدمه كذلك .
وإذا كان العنصران التجريدان النقيان المضيئان يخلقان العالم ، وهو هنا الإسلام ، فلماذا يدخل التناقض في العالم المخلوق من مصدر لاتناقضي ؟ أي كيف يخلق ما هو نقي ما هو ملوث؟ وكيف يصدر الشر عن الخير والمظلم عن المضيء؟
وبطبيعة الحال في عالم حسن حنفي لا تــُطرح مثل هذه الأسئلة ، بل هي تنبث مقطعة مفتتة ، في ثنايا ذلك الفيض اللغوي – الفكري – الاجتماعي – القديم – المعاصر .
ولكن بما أن الوحي يخلقُ العالمَ فهو يتجسد في نص هو القرآن ، وحسن حنفي يقطعُ هنا بين سيرورة التشكل بين الاثنين : الوحي والقرآن ، كما يقطع بين الإله والوحي ، ولهذا نجد أنفسنا عابرين الهوة التجريدية بين الوحي والواقع ، بين عالم الضياء وعالم الفساد ، بين عالم النقاء المتجوهر وعالم الحس والحركة والنقص .
تنقلب العلاقةُ بين الفكرة والواقع هنا ، فبدلاً أن يكون الواقعُ هو الذي أنتج النص ، نجد أنفسنا أمام النص الذي أنتج الواقع ، ولكن التناقض يتفجر هنا ، لأن النص المضيء يخلق واقعاً غير مضيء ، والكامل يخلق الناقص ، وهذه التناقضات الجوهرية الماهوية التي لم تـُحل في بداية البحث سوف تتواصلُ وتتراكب في القادم ، فما بُنى على منهج ميتافيزيقي غيبي في السابق سوف يواصل عرض تناقضاته في اللاحق .
ولهذا فإن قراءة النص داخل تطور الواقع ليست مهمة باحث واحد ، كما يقول حسن حنفي متأسفاً على عدم قيامه بمثل هذه القراءة ، بل المسألة تعود لمنهج مثالي غير قادر على ذلك!(5).
فالعالم المادي ، أو تشكل التاريخ الإسلامي والعالمي ، سيغدو إذن من صنع الوحي ، أي هو مخلوق من عنصر لا مادي ، لكن هذا التشكل لا ينتقل إلينا بصورة تقليدية ، بل بطريقة غير تقليدية ، ورفض كتابة المقدمات في الكتب القديمة هو بداية هذه الطريقة غير التقليدية في صناعة عالٍم ديني إسلامي بذات الرؤى المثالية لدى القدماء .
ومن هنا فحسن حنفي لا يقدم الطريقة التطورية الفكرية – الاجتماعية لقراءة النص والتاريخ الديني ، بل يهجمُ مرةً واحدة على النصوص ، وقد صارت بلا جذور ، وبلا لوحة تاريخية واجتماعية تضعُ الأساسَ لها .
وهي طريقة بحثية متطابقة مع الرؤية المثالية المفارقة ، فلو قام بذلك لكشف الأساس المادي للفكر الديني ، ولكنه لا يريد أن يقوم بذلك .
هذه المنهجية تتيحُ جوهرةَ الوحي ومساراته التالية ، أي جعلَ الوعيَّ الإسلامي متجوهراً في (ذات مطلقة) خارج التاريخ عملياً .
وسيكون كلُ اللاحق متشكلاً بهذه الرؤية المتجوهرة ، فالتاريخُ الإسلامي هنا وقد خرجَ من البنية الاجتماعية التي تشكلَّ فيها ، لن يكون نتاج الصراع الطبقي ، وبالتالي فإننا لن نفهمَ المنتجاتِ الفكريةَ المختلفة التي تشكلتْ في مجرى هذا الصراع الطبقي .
هنا سيحاول حسن حنفي أن يقدم مصادر لهذا التجوهر ، أي كيف يتشكلُ الدينُ وما هو مصدر فكرة الإله ، وفكرة الوحي ، لكن باعتبارها خارج البنية الاجتماعية ، وكمطلقات وكتجريدات خارج التاريخ .
سوف يعتمد في ذلك على المصادر الفكرية الأوربية خاصة الألمانية والفرنسية ، في زمنية خاصة ، هي زمنية الوعي البرجوازي قبيل انفكاكه من هيمنة الإقطاع ، أي وهو في محالةِ مخاضٍ لم يكون بنيةً فكرية مستقلة ، أي توظيف أفكار فورباخ وبرجسون خاصة ، والمنهج الظاهراتي لدى هوسرل .
يقول حسن حنفي وهو يعرض أفكار فورباخ عن الإله باعتبارها أفكاره هو نفسه :
(ليس أمام الإنسان إذن ، إذا ما أراد الحديث عن (ذات) الله إلا التشبيه والقياس ، التشبيه بنفسه والقياس على العالم ، وإثبات أوصاف الإنسان الإيجابية كصفات ثبوتية لله ، ونفي أوصاف الإنسان السلبية كصفاتٍ سلوبية عن الله . وبالتالي يكونُ كلُ حديثٍ عن الإنسان. يتوهمُ الإنسان إنه يتحدثُ عن الله في حين إنه يتحدثُ عن نفسه.)،(5).
وفي الهامش يدعونا حسن حنفي لقراءة بحثه (الاغتراب الديني عند فورباخ) مؤكداً منبع أفكاره .
وهكذا فإن مصدرَ المنتجات الدينية عبر هذه العبارة هو من الإنسان نفسه ، فليس ثمة هنا غيبٌ منتجٌ لهذه المصنفات ، لكنه الإنسان ، ولكن هنا يغدو الإنسان كائناً تجريدياً ، فهو يخلقُ هذه التشكلات الدينية عبر فضاء لا تاريخي ، فتتحول هذه التشكلاتُ الدينية إلى كائنات تجريدية مطلقة كذلك .
وعمليات إضفاء الجوانب الإيجابية من داخل الإنسان على الإله الذي يتصوره ، ونفي الصفات السلبية عن نفسه ، هي كلها عملياتٌ تجريديةٌ غيرُ تاريخية . أي أن حسن حنفي يستوردُ الُمنتجَ الفورباخي ليفسر به الأزقةَ المسدودةَ في منهجه ، فهذا الاستيراد لا يفسرُ السيرورةَ الخاصةَ لتشكلِ صور الإلهة في المشرق في الوعي ، لا من حيث الأنساق ولا من حيث الدلالات،(6).
وهذا بالتالي يطرح إشكالية منهج حسن حنفي في الانقطاع عن دراسة السيرورة التاريخية لفهم فكرة الإله ، كما جرت في المنطقة العربية .
ومن جهة أخرى هذا يتسقُ مع تجوهر المفردات الدينية لديه ، وهي الوحي ، وصورة الإله، اللتان كما رأينا غدتا مجردتين منذ البداية ، ولكنه أضاف هنا تجريدية مطلقة جديدة هي: الإنسان .
فجعلَ هذه المجردةَ المطلقة تفسر المجردتين السابقـتين ، وهذه الطريقة تغدو أنسنة مجردة ، أي أنه يعيد مصدر المنتجات الدينية إلى الأرض ، والإنسان ، ولكن في عالمٍ مجرد ، أي أنه يواصلُ جوهرةَ الوعي الإسلامي وجعله مطلقاً ، غير معبرٍ عن صراعٍ طبقي .
إن العنصرَ الفورباخي المستوردَ هنا يقومُ بقطعِ توجهِ حسن حنفي لقراءة تطور البنية الاجتماعية ، من أجل استكمال فكرته الإيديولوجية التي ستنمو كما سنرى . فهو يعطيهِ وسيلةً لاستمرار التجريد ولتشكيلِ الماهيةِ المتجوهرةِ للوعي الإسلامي النقي .
يعرضُ حسن حنفي عنصراً آخر استيرادياً هو عنصر من برغسون ، فيقول :
(الله إذن ليس موضوعاً للمعرفةِ أو للتصور أو للإدراك أو للتصديق أو للتعبير بل هو باعثٌ على السلوك ، ودافع للممارسة ، وقصد للاتجاه ، وغاية للتحقيق . الله طاقةٌ حالةٌ في الإنسان من أجل أن يحيا ويسلك ويعمل ، ويحس ويشعر ويتخيل وينفعل أيضاً . الله طاقة حيوية يحولها الإنسان إلى فعل)،(7).
علينا هنا أولاً أن نرى التناقضات بين المصدرين الفورباخي والبرغسوني ، ففكرةُ فورباخ عن كونِ الأفكارِ الدينية هي منتجاتٌ إنسانية اغترابية تــُنسف هنا ، وتغدو الأفكار الدينية نتاجٌ خارجيٌ غيبٌي صوفيٌ ، أي تغدو هنا هي أساسُ الاغترابِ غيرِ الُمدرَّكِ وغير المعروف .
إن لحظةَ فورباخ حيث يقومُ هذا الفيلسوفُ بدحضِ الهيغليةِ الدينية الاغترابية بإعادةِ فكرةِ (المطلق) إلى الإنسانِ في تاريخٍ تجريديٍّ ، هي غيرُ لحظةِ برغسون الفرنسي المحافظ ، الذي يقاومُ الفكرَ المادي الفرنسي ، نافخاً في فكرةِ (الطاقة الحيوية) القادمةِ من الغيب والتي لا تتشكلُ في قوانين موضوعية ولا في بُنى اجتماعية!
لكن المنهجيةَ التي يشكلها حسن حنفي جامعاً بين النقائض ومخترقاً الحواجز التاريخية والجمركية السياسية والروحية ، تتشكلُ من غائيةٍ إيديولوجية مضطربةٍ ، بعدم الرجوع إلى قانونيةِ التشكلِ الموضوعي للمنتجاتِ الدينية ، سواءً كانت فورباخيةً ألمانية تنويريةً بروتستانتية مقاومةً للإقطاع ، أم برغسونية كاثوليكية مكرسةً لها ، أم برجماتيةً أمريكية نفعيةً ، فالوعي العملي التوظيفي للأفكار المُنتزَّعةِ من سياقاتها ، يتوجهُ إلى سدِ الثغرات في ثقوبِ ثيابه الإيديولوجية بالرقع المناسبة .
فهو إذ يعيدُ الدينَ إلى منتجهِ الإنسان يستعينُ بفورباخ ، وإذ يعيدهُ مرةً أخرى إلى السماء يستعينُ ببرغسون ، ويحوله إلى طاقةٍ حيوية مجردةٍ ضائعةِ الملامح الطبقية مرةً أخرى ليشكلَ مشروعَهُ المتجوهرَ حول الذاتِ الدينية غير المتكونةِ داخلَ سيرورةِ البنى الاجتماعيةِ وقوانينها .
فالهيكلُ الإيديولوجي السياسي العائدُ للباحثِ يقومُ بتوظيفِ مختلفِ العناصر لذاته ، غير مراعٍ للخصائص المتضادةِ للعناصر التي يركبها حول نفسه .
وبطبيعةِ الحال فالمصادرُ تختلفُ من حيثِ نموها في المشروع ، فالعنصر البرغسوني يغدو مجردَ دافعٍ عام ، تتمظهرُ فيه عمليةُ تدفقِ اللغة ، أي أن العنصرَ الحيوي التجريدي الصوفي البرغسوني يغدو لدى حسن حنفي طاقةً عاطفيةً ضخمةً تنهالُ فيها الجملُ والأفكار بسيلٍ جارف . لكن نحو الواقع ونحو رؤية التجسيدات الإسلامية المختلفة .
في حين يلعبُ المصدرُ الفورباخي عملياتٍ كثيرةً في المشروع برفضِ التجريدات الدينية الغيبية فتجري أنسنتها في الكثيرِ من المجالات . فعملياتُ الاغترابِ يجري دحضها في الرموزِ الدينية المختلفة ، ولهذا حين يتوجهُ إلى فصلِ أي عنصرٍ ديني مفارقٍ لا يقرأهُ في بنيتهِ الاجتماعية وسيرورتها بل يدحضهُ من خلالِ الأنسنةِ العامة ، أي عبر منهج فورباخ، مع أدلجة سياسية مباشرة تأتي في خاتمة الفقرة عادةً تحضُ على النضال المباشر بذلك الوعي المتجوهر المطلق ، ولكنه الآن فقدَ انفصالَهُ عن العمل لكن لن يُــكشف محتواه الطبقي .
وإذا كانت هذه المصادرُ تلعبُ دوراً في تشكيل المنهج فلا بد أن الظاهراتية والبنيوية النصوصية تكملان المنهجية ، فقراءة الظاهر والنص المحدد ، تتداخلان و تكتملان .
فالوعي الديني يغدو ظاهراتيةً مباشرةً تــُرصدُ بمباشرتها فيتمُ الوصول إلى أنساقٍ في نصوصها ، المقطوعة الجذور عن الصراع الاجتماعي ، فعلمُ الكلام الإسلامي مثلاً يُؤخذ بكتبه وموضوعاته ، بأسمائها وفصولها وتطور هذه الموضوعات عبر الزمن ولماذا ازدادت الإلهيات على الطبيعيات أو كيف نمت الموضوعات السماعية الخ . . .
يقول في إحدى خلاصاته عن علم الكلام :
(علم الكلام إذن هو تاريخ الأهواء والأغراض والمصالح أكثر منه تاريخاً للعقل ، ثم ورث الهوى العداوة والبغضاء في النفوس وضاعت وحدة العقل في تكثر الأهواء ، وتلاشت وحدة الوحي في تضارب الرغبات والمصالح). (قضى علم الكلام على بساطة الوحي ووضوحه)،(8).
على الرغم من الدخولِ الوثيقِ البالغ التفاصيل والجهدِ في كتبِ علم الكلام فإن حسن حنفي يأخذهُ كنصوصٍ ذاتِ موضوعات ، وليس كتاريخٍ من الصراعِ الفكري الاجتماعي المتداخل.
ليس ثمة عقلٌ مجردٌ في هذا التاريخ ، بل هنا نجدُ العقولَ الدينيةَ في صراعاتها المختلفة، فقد أسس علمُ الكلام دوراً تحضيرياً تمهيدياً للفلسفة الدينية ، وعبَّر عن نضال الفئات الوسطى في تشكيلِ سببية دينية للحرية الفردية ، وبهذا فإن علمَ الكلام الاعتزالي هو مشكلٌ لهذه النضالية المحدودة ، وعلم الكلام الأشعري هو هادمها ورابط تلك الفئات الوسطى بالنظام الإقطاعي المذهبي المسيطر .
وهكذا فإن العقلَ الديني المنقسمَ ليس مقسوماً بشكلٍ تجريدي بل هو مقسومٌ لأسباب اجتماعية صراعية ، أي متشكل في تيارين رئيسين ، يعبران عن منحيي النضال ثم التبعية في هذه الفئات الوسطى وتاريختيها الخاصة في المنظومة وبسببِ سيرورةٍ خاصة للمنظومةِ الاجتماعية التاريخية غير القادرة على تجاوز تناقضاتها ، فنمو وسيطرة الأشعرية ليس هو لأسبابٍ تجريدية ، بل هو لأسبابٍ طبقية وفكرية متداخلة .
إذن هو تاريخٌ للعقل ، ولكن في سيرورتهِ الدينية ، في زمنيةِ الإقطاع ، وثمة عناصر مقاومة وثمة عناصر استسلام ، ثمة عناصر كفاح للإرادة تنتمي لتلك الفئات لم تصل أن تربط نفسها بالجمهور العريض لأسباب عميقة وخطيرة ، هي النظام الاجتماعي غير المدروس عند حسن حنفي ، وحتى العناصر السلبية فيها كذلك جوانب معينة إيجابية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
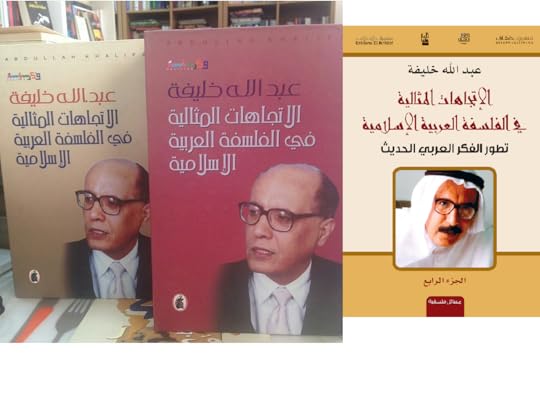
انظر عبـــــــدالله خلــــــــيفة: الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية ، الجزء الرابع ، تطور الفكر العربي الحديث , وهو يتناول تكون الفلسفة العربية الحديثة في مصر خاصة والبلدان العربية عامة، منذ الإمام محمد عبده وبقية النهضويين والمجددين ووقوفاً عند زكي نجيب محمود ويوسف كرم وغيرهما من منتجي الخطابات الفلسفية العربية المعاصرة ، 2015.
(المصادر) :
(1) : (التراث والتجديد ، المجلد الأول ، حسن حنفي ، مكتبة مدبولي ، بدون تاريخ أو رقم للطبعة ، ص 10) .
(2) : (المصدر السابق ، ص 49) .
(3) : (المصدر السابق ، ص 58) .
(4) : (المصدر السابق ، ص 59) .
(5) : (يوضح حسن حنفي رفضه للقراءة المادية للتراث في كتيب أصدره بعنوان (دعوة للحوا) ، يقول في إحدى مقالاته فيه : فالماركسية مثلاً ما زالت تعتبر الدين مثل الثقافة والفن وسائر النشاط الذهني الإنساني أبنية فوقية تعبر عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية لشعبٍ ما في لحظة تاريخية معينة . يمكن تغييرها بتغير ملكية وسائل الإنتاج، من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة ، وبنقل نمط الإنتاج من الزراعة إلى الصناعة . بهذا التحول تتغير الثقافة آلياً وتنشأ مفاهيم أخرى لزمان والعمل والإنسان والعلاقات الاجتماعية أكثر تطوراً وحداثةً) ، (دعوة للحوار ، الهيئة العامة للكتاب 1993 ، ص 119 ، لنلاحظ هنا أن أفكار حسن حنفي بعد (غربلة) التراث لم تختلف عن أفكار محمد باقر الصدر برفض وجود قوانين لتطور البُنى الاجتماعية وفهمها بشكل تقني ، واختزال فهم مستويات البناء وطرح الآلية كشكل وحيد للتغيرات وبدون عوامل نضالية وتداخلات معقدة!
(5) : (المصدر السابق ، ص 87) .
(6) : (راجع عملية تحلينا لتطور المسار الديني في المشرق في الفصل الأول من الجزء الأول من الاتجاهات المثالية) .
(7) : (من العقيدة إلى الثورة ، المصدر السابق ، ص 88) .
(8) :(المصدر السابق ، ص 118) .
العقل عند طه حسين
إن اقتراب طه حسين من الفكر الفلسفي نجده في الصفحات الأولى من كتابه: (مستقبل الثقافة في مصر) الذي يقدمُ فيه خطةً عامة لتغييرِ نظام التعليم في مصر، والجمعُ بين هذا الفكرِ النظري العام وقضيةِ التعليم تحديداً، هو قمةُ عمل النهضويين (العلمانيين)، الذين اقتصروا على البثِ الثقافي وليس العمل السياسي والاجتماعي المباشر، حيث صعّد طه حسين تدريجياً التنويرَ الأدبي ليغدو نضالاً سياسياً تبلور عند التعليم، وذلك بسبب تصور التنويريين المثالي عموماً بكونِ الثقافةِ هي أداةُ تغيير التخلف، لكن هذه الثقافة مصاغةٌ داخل آليات بنية الإقطاع المذهبي وليس لاجتثاث هذه البــُنية مما يؤدي بهذه الثقافة نفسها أن تكرس تلك البنية لا أن تهدمها كما كانوا يتصورون.
ولهذا فإن منطلقات عميدِ الأدب طه حسين شبهِ الفلسفية في مقدمة هذا الكتاب تتطابقُ وخطته لتغيير التعليم في مصر التي أعلنها في هذا الكتاب سنة 1938 ثم طبق أساسياتها حين صار وزيراً للتعليم في حكومة الوفد بعد ذلك.
وفي هذه المنطلقات فإن مسألة (العقل) تغدو بؤرةً مركزيةً في عمليةِ إنتاجِ المفاهيم وتطبيقها، ولهذا يقول :
(فهل العقل المصري شرقي التصور والإدراك والفهم والحكم على الأشياء، أم هل هو غربي التصور والإدراك والفهم والحكم على الأشياء؟ وبعبارة موجزةٍ جلية أيهما أيسر على العقل المصري : أن يفهمَ الرجلَ الصيني أو الياباني، أو أن يفهم الرجلَ الفرنسي أو الإنجليزي؟)، (31).
يعممُ طه حسين الوعيَّ المصري وتياراته في أزمنته المختلفة في تعبيرٍ متجوهر هو (العقل) مما يُعطي لهذا العقل خصائصَ عامةً مجردةً خارجَ الزمان والمكان. فالعقلُ المصري يغدو بهذا الوعي واحداً سواء كان في زمنِ التاريخ المصري القديم في زمن الفراعنة أم كان في زمن التبعية لليونان والرومان أو زمن الدخول في السيطرة العربية أو في زمنه الحديث، فكل هذه التشكيلات التاريخية والسيرورة الاجتماعية لا تغير من طبيعة العقل المصري الواقف فوق الوجود.
ولهذا فإن (العقلَ) المصري وهو يشتبكُ مع الغزاة والعقول الأخرى يظل محتفظاً بهويته الجوهرية حسب منطق طه حسين المثالي المفارق، وهذا العقلُ الذي يجعله حضارياً بشكلٍ ميتافزيقي منذ أن ظهر في الوجود، يصطدمُ مع التأثيرات الشرقية غير العقلانية مثلما غزا الفرسُ مصرَ رغم أنهم كانوا تعددين بخلافِ ما يعرضُ طه حسين هنا أي لم يفرضوا ديناً : (ومعنى هذا كله واضح جداً : وهو أن العقل المصري لم يتصل بعقل الشرق الأقصى اتصالاً ذا خطر، ولم يعش عيشة سلم وتعاون مع العقل الفارسي، وإنما عاش عيشة حرب وخصام) (32).
إذن إذا كان هذا العقلُ متجوهراً على نفسه وخارج الشرق وهو فيه، كيف يستمدُ مقوماتِهِ وكيف ينتجُ عقلانيتَه؟
يقول الدكتور طه حسين بأن بناءَ العقل يتمُ من خارجه عبر المحيط الجغرافي فيقول: (أن العقل المصري منذ عصوره الأولى عقل إن تأثر بشيء فإنما يتأثر بالبحر الأبيض المتوسط)، (33).
ومن هنا فهو يجعلُ العقلَ المصري (أوربياً) قبل أن تظهر أوربا الرأسمالية الحديثة، لكن عبر نموذجها الأولي المتمثل في حضارة اليونان، التي قام العقلُ المصري نفسه بتغذيتها بالعلوم والفنون، ولكن هذه التغذيةَ الثقافية تظهرُ في شريطِ طه حسين التاريخي بلا سببيات وبشكلٍ مجردٍ، ولكنه وهو في هذا التجريد يستدركُ قائلاً بأنه من الحق (أن نعترف بأن مصر لم تنفردْ بالتأثير في حياة اليونان، ولا في تكوين الحضارة اليونانية والعقل اليوناني، وإنما شاركتها أممٌ أخرى، كان لها حظٌ موفورٌ من الحضارة والرقي..)، (34).
إن العقلَ الحضاري إذن هو من نصيبِ جماعاتٍ تعيشُ على ضفافِ البحر الأبيض المتوسط، وكأن في هذا البحر خصائصَ سحريةً تعطيه قدرةَ جعل الشعوب العائشة على ضفافه أن يكونَ لها عقلٌ وحضارة، وليس أن هذه الحضارات نتاج أساليب الإنتاج المتقدمة والمتباينة فيما بينها، ولهذا فإن طه حسين لا يعرضُ أسبابَ الديمقراطية اليونانية وانتفاء هذه الديمقراطية من أساليب الحكم الشرقية (الحضارية)، ولا مظاهر كون الثقافة اليونانية متعددة من مادية ودينية في حين كان الشرق دينياً شمولياً، ولهذا فإن ميزات هذا العقل المصري أو الشرقي الحضاري عامةً، الشمولي الديني يُطَّابقُ بالعقلِ اليوناني المتعدد الأفكار، وهو أمرٌ يقودُ إلى إخفاءِ التباين العميق بين الثقافة في ظل أنظمة العبودية العامة كما في مصر والعراق والشام، التي سادتها الأديانُ الحكوميةُ المستبدة، وبين اليونان التي عرفت الاتجاهات الفلسفيةَ المادية المتنوعة ثم الاتجاهات المثاليةَ المتعددة بعد ذلك، بسبب تعدديةِ المدن والسلطات وظهور برجوازية حرة.
وخلافاً لرأي طه حسين البحري فإن ظهورَ العقل الديمقراطي في اليونان نتاجُ تطور الصناعات والتجارة الحرة غير المحكومة بإدارة الدولة، وهي الظروف التي أتاحت التعليم الحر والثقافة الحرة، بعكس ما فعلته المنشآتُ التعليمية الكهنوتية المصرية والعراقية والشامية الخ، ولهذا فإن الموادَ الثقافيةَ المشرقية المقدمة إلى اليونان المفيدة والمؤدية للتطور لم تؤخذ في زنازينها الحكومية الغيبية المشرقية، بل أُدرجت في أبنيةِ مدنٍ يونانية مختلفةِ الاتجاهات، وفي المدن الديمقراطية أدى ذلك إلى فلسفات مادية ومثالية موضوعية كفلسفتي ديمقراطيس وأرسطو، وفي مدن استبدادية وعبر نمو الاستبداد في المجتمع اليوناني عامةً أدى ذلك إلى ظهور فلسفات مثالية دينية معادية للعقل الخ..
إن فصلَ طه حسين العقلَ المصري عن منطقتهِ العربية – الإسلامية – المسيحية الشرقية وتعليقه في فضاءٍ جغرافي لا تاريخي، أي وضعَهُ داخلَ إطار ما أسماه (أسرة الشعوب التي عاشت حول بحر الروم) ص 14، يستهدفُ غايات تحويلية شمولية تحديثية، أي بمعنى إن عمليةَ الفصلِ هذه التي تــُشكَّل بمنهجيةٍ لا تاريخية تجريدية، تسحبُ مصرَ من سيرورةِ تكونها الاجتماعية التاريخية الموضوعية الحقيقية، وتعلقها في وعي مُسقطٍ على التاريخ وهو وعيٌ شموليٌ إداري حكومي، وليس بمنهجية ديمقراطية شعبية، فتقومُ هذه المنهجيةُ بفصلها عن تكونها الحقيقي، وتوجدُ لها رابطةً موهومة، هي رابطةٌ إيديولوجية مُسقطة من مثقفٍ تنويري يستهدفُ غايةً جيدة لكن بشروطِ وعي غير علمية.
ومن هنا يهاجمُ الشكلَ العادي الموضوعي المبسَّط من الوعي العام مصراً على قطعهِ لمصرَ عن نسيجِها العربي الإسلامي المسيحي الشرقي: (فأما المصريون أنفسهم فيرون أنهم شرقيون، وهم لا يفهمون من الشرق معناه الجغرافي اليسير وحده، بل معناه العقلي والثقافي)، ( ولكني لم أستطع قط، ولن أستطيع في يومٍ من الأيام، أن أفهمَ هذا الخطأ الشنيع أو أسيغ هذا الوهم الغريب.) (35).
إن طه حسين وهو يستهدفُ غايةً نبيلةً وهي ربطُ مصر بأوربا النهضوية الحديثة يستخدمُ منهجاً إيديولوجياً يحطمُ فيه أسسَ التاريخ ويشكلُ تاريخه الإيديولوجي الخاصَ الموظفَ لخدمةِ تلك الغاية السابقة الذكر.
يقول: (ومن المحقق أن تطور الحياة الإنسانية قد قضى منذ عهد بعيد بأن وحدة الدين، ووحدة اللغة، لا تصلحان أساساً للوحدة السياسية ولا قواماً لتكوين الدول) ويضيف: فالمسلمون أنفسهم منذ عهد بعيد قد عدلوا عن اتخاذ الوحدة الدينية واللغوية أساساً للملك وقواماً للدولة.)، (36).
إن طه حسين هنا يرفض بديهيات التاريخ، فعلى العكس كانت الوحدةُ الدينية – اللغوية أساسَ تكونِ الدول القديمة، فالإمبراطوريةُ الإسلامية قامتْ على تلك الوحدة المزدوجة، وكانت تلك الوحدة في بدايتها عملية نهضوية واسعة، وبهذا فإن الإسلامَ واللغةَ العربية وضعا أساسين لتشكلِ ولنهضةِ أممٍ متعددة، ولكن نظراً لسيطرةِ طبقةٍ استغلالية في مركز هذه الإمبراطورية ورفضها عمليات الإصلاح من قبل الفئات الوسطى المدنية، فإن هذه الإمبراطوريةَ تفككت، وبالتالي بدأت اللغاتُ القوميةُ في الظهور وإزاحة اللغةِ العربية في بعض الأقطار، في حين احتفظت أقطارٌ أخرى بهذين الأساسين، فيما عُرف بالدول العربية الإسلامية. وظل هذان الأساسان فيها، حتى حاولت الإمبراطوريةُ التركيةُ تغييرَ الأساس اللغوي العربي لحضارةِ المنطقة فلم تستطع.
والغريب في منطق طه حسين أنه ينقلبُ عن هذا الرأي حين يمنهجُ التعليمَ في مصر معتبراً الإسلامَ واللغة العربيةَ أساس هذه المناهج التربوية حتى في المدارس الأجنبية!
وفي رؤية طه حسين هنا نقرأ تعميمات تجريدية خاصة في تعبيري (الدين) و (اللغة)، فالدين، الإسلام، لم يعدْ هو أساس وحدة الإمبراطورية الإسلامية أو الدولة الإسلامية، بل المذهب، فالأساسُ الإسلامي العام التوحيدي زال، وغدت الدولة مذهبيةً، والمذهبُ الديني الموظفُ حكومياً صار أداةَ السيطرة للطبقة الإقطاعية، مُفرغَّـاً من طابعهِ الإصلاحي ومحوَّلاً إلى أشكالٍ مُفرَّغةٍ من دلالاتها الشعبية النهضوية الأولى، كما أن (اللغة) العربية الفصحى تيبست ثم أصبحت محصورةً في دوائر ضيقة بسببِ سياسةِ تلك الطبقات الإقطاعية في تقليصِ الثقافة والتعليم وحياة المنتجين المادية وبالتالي أدى هذا إلى تكونِ وصعودِ اللهجات العامية الخ..
ولكن هذين الأساسين – أي الدين واللغة – تشكلا في زمنِ الدول التقليدية، أي في زمن سيطرة الإقطاع، وبالتالي فإن مسار التعميم لدى طه حسين، كما هو سائد كذلك في الوعي العربي التقليدي عامةً، ليس دقيقاً فالانتقال من الإسلام العام إلى المذاهب هو أمر مختلف، بمعنى أن انتقاله من شكلٍ إلى شكلٍ آخر، هو بسببِ جملةٍ من التغيرات والصراعات التي انعكست على البنية الداخلية في الدين. أي بسبب انتقال الإسلام من دين شعبي إلى دين حكومي مُسيَّطرٍ عليه من قبل الأقليات الاستغلالية.
ولهذا فطه حسين بعد أن أنتزعَ مصرَ من سياقها العربي الإسلامي وعلقها في فضاءِ بحرِ الروم حيث تنتمي إلى دائرة الأمم الأوربية، عاد وأفرغ التاريخَ العربي الإسلامي من دلالاته الموضوعية وتطوره الحقيقي، يقول :
(فأما نحن فقد عصمنا الله من هذا المحظور ووقانا شروره التي شقيت بها أوربا. فالإسلام لا يعرف الأكليروس ولا يميز طبقة رجال الدين من سائر الطبقات. والإسلام قد ارتفع من أن يجعل واسطة بين العبد وربه. فهذه السيئات التي جنتها أوربا من دفاع رجال الدين عن سلطانهم لن نجنيها نحن إلا إذا أدخلنا على الإسلام ما ليس فيه وحملناه ما لا يحتمل.)، (37).
إن هذه لغةً تجريدية لم تدرس المسار الفعلي لتطور الدولة العربية الإسلامية، فعبر تحول الدولة الإسلامية من دولة (شعبية) إلى دولة للأشراف تم إعادة تشكيل الوعي الديني المسيطر، وكذلك غُيرت طبيعة رجال الدين حيث قــُرب الموالون وصارت الأحكام تراعي دول الاستغلال، وأُضطهد المعارضون، ونـُحيت مسألة الملكية العامة العائدة للمجتمع وتم تشكيل أشكال مذهبية معارضة متعددة، ولكن عموماً لم يستطع المدافعون عن الجمهور أن يشكلوا فقهاً مسيطراً، في حين سيطر الفقهُ الموالي لدول الاستغلال على تعدد أوجهها المذهبية.
وبهذا نشأ لدينا أكليروس من طبيعة مختلفة عن الأكليروس الأوربي، الذي كان وحده على السلطة في العصر الوسيط، في حين كان الأكليروس الديني لدينا مجردَ تابعٍ ومشاركٍ للسلطةِ السياسية، لكنه كان اكليروس كذلك!
لقد صارت السلطة دينيةً وصار المذهب سياسياً وكلاهما مشكلان من قبل طبقات الأقلية الحاكمة، ولهذا فإن أوجه النهضة الفقهية والأدبية والفكرية المضيئة هي من إنتاج الفئات الوسطى التي حاولت أن تقاومَ ذلك التكريس المحافظ ولكنها لم تستطع أن تحيلها إلى ثقافة سائدة، وقامت قوى الأقلية بإعادة صهر النتاج الديني الثقافي ليصير على ما هو عليه في القرون الأخيرة من تكلس وتبعية للهيمنة الحكومية.
ولهذا فإن خلاصةَ طه حسين تبدو مضادةً للواقع: (فالمسلمون إذن قد فطنوا منذ عهد بعيد إلى أصل من أصول الحياة الحديثة، وهو: أن السياسة شيء والدين شيء آخر، وأن نظام الحكم وتكوين الدول إنما يقومان على المنافع العملية قبل أن يقوما على أي شيء آخر.)،(38).
ولننتبه هنا إلى كلمة (أصل من أصول الحياة الحديثة) وهي كلمةٌ لم يصرح بها طه حسين وهي كلمة (العلمانية) أي فصل الدين عن السياسة، ولكن هذا الفصل لم يحدث إلا بشكلٍ جزئي، فالحكامُ كانوا سياسيين ولكنهم مذهبيون كذلك، أي أن سيطرتهم على المنافع العامة جعلتهم يسيسون الدين بشكل معين، إلا أن عملية الفصل الشاملة بإعطاء الإسلام حريته لم تحدث، وظلوا مهيمنين على إنتاج الدين وإنتاج الثروة معاً، واستمر ذلك حتى زمن طه حسين وهو يكتب كتابه.
إن عدم تحليل طه حسين لسيرورة الإسلام بشكل موضوعي، أي تعليقه في فضاء مجرد من الصراع الاجتماعي، في الماضي، يقوده إلى إنتاج نفس الخريطة المجردة في العصر الحديث. أي على إبقاءِ الدينِ خاضعاً للأقليةِ الغنية المسيطرة على الثروة والسلطة.
ولهذا فإن طه حسين وهو يكتب كتابه السابق الذكر (مستقبل الثقافة في مصر) كان يتصور عملية الفصل بين الدين والسياسة قد تمت لدى المسلمين وليس ثمة حاجة للنضال من أجلها، وأن مصر الدينية الإقطاعية في عصره مماثلة في وجودها الاجتماعي لأوربا الرأسمالية العلمانية، وهذا التصور قد تشكل بسبب عدم قراءته للتطور الاجتماعي المختلفِ بين المشرق وأوربا، فهو أولاً يعزلُ مصرَ عن نسيجها الجغرافي الاجتماعي، معلقاً إياها في فضاءٍ إيديولوجي تنويري مثالي، جاعلاً إياها متجوهرةً مرتفعةً عن بُنى التاريخ الموضوعية، ثم ينقل هذا التجوهر إلى مفردات الدين والعصر. فتنتفي الفروقُ النوعية بين تطورِ مصر الإقطاعية المذهبية وتطور أوربا الرأسمالية العلمانية. فكلاهما سواء ولا تحتاج مصر لتكون أوربية كاملةً سوى إلى اندماج ثقافي حداثي وليس إلى تغيير سياسي واجتماعي كبيرين. أي أنه يقفزُ على مهمةٍ كبرى لم تنجز.
إن كتاب (مستقبل الثقافة في مصر) الذي كتبه طه حسين هو محاولة لإنتاج عقل حديث، ولكنه يعجز عن إنتاج مثل هذا العقل، كما فعل ديكارت في فجر التحديث الأوربي. فديكارت الذي توجه نحو الفلسفة أنتج معرفة لادينية، أي معرفة تفتحُ الطريق لنمو التجريبية الخالصة ولتحرير العلوم الطبيعية من أسر الكهنوت. في حين توجه طه حسين للأدب، وشكل عقلاً مجرداً لا تاريخياً، كرس المحافظة الدينية الميهمنة على المناهج التربوية.
فصياغته لعقلٍ مجردٍ لا تاريخي ولا طبقي، جعله يجردُ الدين واللغة والثقافة عموماً من كونها أدوات في الصراع الاجتماعي، فالفكر الديني المحافظ الذي كرسه الإقطاع المذهبي عبر القرون السابقة، ليس هو منتجٌ إسلاميٌ عام، بل هو منتجُ الأشراف والقوى العليا التي هيمنتْ على المسلمين والمؤمنين عموماً. ولهذا فبدون فحصِ ونقد هذا المُنتَّج المتنوع وتقديمه خاماً مسيطراً على العقول عبر التعليم، لا يؤدي ذلك إلى خلق عقل (تنويري) بل يؤدي إلى توسيع المحافظة الدينية اليمينية، وحين يخطط ثم يبني طه حسين تعليماً متوسعاً ديمقراطياً في امتدادته، ثم يقدمُ نفسَ المادة الدينية المحافظة فهو يقوي الاتجاهات غير التنويرية التي أراد تغييرها. إنه يوسعُ التعليمَ لكي تسيطر عليه القوى الشمولية خلافاً لأمنيته.
يقول:
(ولا يخطر لأحدٍ من أشد الناس محافظةً أن يحظر درس بشار وأبي نواس ولا أن يطلب من السلطان تحريق ما ورثنا من آثار الفلاسفة والزنادقة والمجان الذين لا يرضى عنهم الدين..)، (39).
إن هذا الذي يستبعدُ طه حسين في زمنه وقوعه قد حدث فعلاً في زمن تالٍ، وهذا يعودُ لأن قادةَ الفئات الوسطى الفكريين والسياسيين، طرحوا مفاهيمَ مجردةً كمسائل العقل والدين واللغة والثقافة عموماً، ولم يدرسوها كمنتجات في بُنى اجتماعية متضادة القوى والطبقات، وبالتالي قاموا بالترويج لفكر العصر الوسيط المحافظ، وكانوا يقولون بأنهم يعيدون إنتاج أوربا الحديثة مصرياً وعربياً.
إن طه حسين يجعلُ طبيعةَ الدولة المصرية المعاصرة وطنية عامةً مجردةً : (أول واجبات الدولة أن تحمي بعض المصريين من بعض)، فتغدو الدولة هنا جهازاً فوق الطبقات، مثلما جعل الثقافةَ وعياً فوق الطبقات، وجعل فلسفةَ ديكارت والفلسفة الأوربية الحديثة عموماً شكلاً إنشائياً: أنظر قوله (إن الذين يزعمون أن ديكارت كان خلواً من الروح إنما يقولون سخفاً ويهذون بما لا يعلمون)، ص 67. فهل هي قضية ديكارت الروح أم قضيته فصل الفلسفة عن الدين وخلق اتجاه تجريبي علماني؟
وتغدو الديمقراطيةُ لدى طه حسين كذلك تنويراً ثقافياً وليس بنيةً حديثة ذات قوانين مختلفة عن قوانين بنى العصر الوسيط.
إن هذه اللغةَ الإنشائيةَ الخطابية غير التحليليةِ غير الفلسفيةِ، لن يكون بإمكانها أن تناقشَ القضايا المحورية في البنية الاجتماعية المعاصرة، أي أن تربط مسائل الثقافة وعلاقتها بالتشكيلات التاريخية، وأن تقرأ أنواعَ الوعي المرتبطة بالطبقات، وأن تحدد مسارَ التحول ونشاط القوى الفاعلة الثورية، وبهذا فإن هذه الرؤية لا تصل إلى المفاهيم المجردة الفلسفية العامة كالضرورة والسببية والحرية والقانون الاجتماعي والطبيعي الخ.. وهي عبر وعيها الأدبي تريد أن تقيمَ استراتيجية اجتماعية كبرى، ويترافق هذا مع فئات وسطى متداخلة مع الإقطاع، فتغدو الحداثة متداخلةً مع المحافظة الدينية، وتصير العلمانية في نسيجٍ كهنوتي، وتعجزُ الفئاتُ الوسطى عن التحول إلى طبقة وسطى قادرة على تجاوز التشكيلة الإقطاعية المذهبية.
وفيما بعد يضيفُ النظامُ العسكري الوطني الشمولي مشكلات أخرى إلى هذا التصدع الداخلي لتطور الفئات الوسطى باتجاه الحداثة والديمقراطية، فهو يزعزع فئاتها الصناعيةَ ويخلقُ بيروقراطيةً اقتصادية كبيرة تتوجه إلى الفساد، مما يكرس المحافظة الدينية ويؤدي إلى ضمور العقل النقدي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
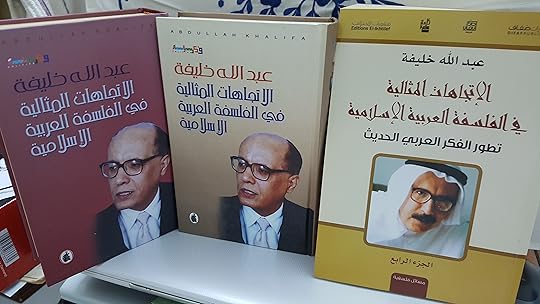
انظر عبـــــــدالله خلــــــــيفة: الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية ، الجزء الرابع ، تطور الفكر العربي الحديث , وهو يتناول تكون الفلسفة العربية الحديثة في مصر خاصة والبلدان العربية عامة، منذ الإمام محمد عبده وبقية النهضويين والمجددين ووقوفاً عند زكي نجيب محمود ويوسف كرم وغيرهما من منتجي الخطابات الفلسفية العربية المعاصرة ، 2015.
بداية المثالية الموضوعية
إن تشكلَ المثاليةِ الموضوعية الفلسفية الدينية المعاصرة في البدء كانت لدى بعض الدارسين والمتخصصين في الجامعات أو الحوزات الدينية مثل يوسف كرم المصري ومحمد باقر الصدر العراقي، وفي نصوصهما الفلسفية تتشكلُ حالة مواجهةٍ مع الفلسفاتِ التجريبية الذاتية أو مع المادية الجدلية.
فهما يرفضان التصورية أو المثالية الذاتية حين ترفضُ هذه المثاليةُ الاعترافَ بأساسياتِ الوجودِ العامةِ فقومُ بحصر مركز الوعي في الذات المفصولة عن الوجود الموضوعي، ويقوم المفكران المسيحي والمسلم، كلٌ من جهته، بربطِ الوعي بالوجودِ والاعتراف بموضوعة المعرفة، وهذا يفتحُ البابَ لقراءة المجتمع ونقده والمطالبة بإصلاحهِ بهذا الشكل أو ذاك.
وإذا كان يوسف كرم لا يدخل في عملية التحليل والنقد الاجتماعية، أي لا يربط بين هذه المثالية الموضوعية وقوانين الوجود الطبيعية والاجتماعية، فإن محمد باقر الصدر يتوسع في هذه العملية ويبحث عن سببياتِ الوجودِ الطبيعية والاجتماعية، دون تحديد مدى قانونية المثالية الموضوعية هذه، وهذا اللاتحديد أو التحديد الإصلاحي المحدود يرتبط بالهياكل السياسية والاجتماعية التقليدية هنا، فلم تقدر المثالية الموضوعية أن تتصف بقدر نقدي مهم، أي أن انتماءها الاجتماعي لم يتحول إلى الطبقة الصناعية المالكة الحديثة كقائدة لعملية تحولٍ منتظرة.
علينا أن نرى في ظهور المثالية الموضوعية لدى يوسف كرم المسيحي؛ ومحمد باقر الصدر الاثناعشري، ليس فقط تجلياً شخصياً للفلسفة الدينية، المشرقية القديمة وهي تستعيدُ نشاطها في المشرق العربى – الإسلامي – المسيحي مرة أخرى، بل هي تجلٍ عام كذلك، لكنها الآن فقدت الوسائط النجومية الكوكبية التي كانت ترافقُ فكرة الإله أو صورته في عملية صنع الوجود.
ولهذا فإن عملية الفقه النقدي لدى محمد باقر الصدر مهمة في تدشين حفر تحليلي للواقع يترابط والمنظومة المثالية، لكن من موقعِ الخصام العنيف مع المادية الجدلية، وهو أمر قاد إلى عدم تطوير لحظته الفلسفية المهمة فيما بعد اغتياله . وقامت القوى المذهبية بالتراجع عن حيوية أفكاره، ولكن هذا أيضاً لن يكون أبدياً، فهناك مخاضٌ يدفعها لإجراء تحولات عميقة في بناها التقليدية.
فباقر الصدر نا يواجهُ فلسفةَ المادية الجدلية الاستيرادية في مرحلة الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين حيث تتقابلُ على أرض العراق هذه المعسكرات المتضادة بشكلٍ حاد، وتقودهُ عمليةُ (تفنيدِ) المادية الجدلية إلى الاعتراف بموضوعيةِ الوجود وسببياته، لكن قانونيةَ الوجود الاجتماعي تصيرُ مرفوضةٍ لديه، فالبُنى الاجتماعية بقوانيتها الموضوعيةِ تتحول إلى سببيات جزئية مثالية، أي أن تغيرات المجتمع تعود لديه إلى أسبابٍ تربوية وفكرية ذات أساسٍ غيبي في نهاية العطاف.
وبهذا فإن قانونية الوجود راحت تتكسر فى الوعي الديني عامةٍ، وأخذت المثاليةُ الموضوعية عموماً تتوقف أو تترجع إلى أشكالٍ فلسفية مثالية ذاتية أو تعود للتصوف، وهوشكلٌ مثالي ذاتي كذلك . لكن نمو المثالية الموضوعية من منطلق ديني، لن يتوقف فسنجد اشعاعاً فيها عبر المذاهب السنية هذه المرة، وبشكلٍ موسوعي، خاصة في أعمال محمد عابد الجابري وحسن حنفى.
لكن بعد أعمال يوسف كرم نجد ظهور واتساع البرجماتية والتجريبية المنطقية والوجودية، خلافاً للبواكير المشجعة لنهوضِ المثالية الموضوعية، ويعود ذلك لعدم قدرةِ المثاليات الموضوعية على التطور، فالشكلُ الديني المحافظ سياسياً حبسها عن النمو، فيوسف كرم عبر مسيحيته ومحمد باقر الصدر عبر اثناعشريته، كانا يجعلان المثالية الموضوعية تابعةٍ للوعي الديني المهيمن والشمولي، وإذا كان الاعترافُ بقانونية الوجود الموضوعية تحت عدة أقواس، مهماً في الوجود الطبيعي فإنه في الوجود الاجتماعي أكثر أهمية ولكن أكثر صعوبة وخطورة.
ولكن هنا لا تظهر عمليةٌ نقديةٌ جذرية للمجتمع عبر المثالية الموضوعية، فهي سوف تعيدُ سببيات الحياة الاجتماعية إلى التربية والوعي، وليس إلى بنية المجتمع الطبقية الحاسمة. رغم اتفاق مثالية محمد باقر الصدر مع المادية الجدلية على أهمية وجود قطاع عام في إسناد الطبقات الفقيرة وعلى دورهِ في عمليةِ التنمية والقبول بالإصلاح الزراعي في حدود.
الأيديولوجيات العربية والعلم
هناك بعض أوجه التشابه بين التجربة الماركسية — اللينينية والتجارب العربية الفكرية والاجتماعية القومية والدينية، فهناك جوانب عميقة متقاربة، فالمنهجية الماركسية التقليدية لم تتشكل كحفرٍ علمي في العلوم عربياً وإسلامياً ، فهي جاءت كمقولاتٍ ناجزةٍ، فليس ثمة هنا أبحاث واسعة في العلوم، ولا تشكيل لطبقة فكرية موضوعية على سطح الوعي، وبالتالي فإن تطبيقها على ميدان التاريخ والبنى الاجتماعية كان يجري بالطريقة ذاتها، أي كعمليةِ نقلٍ من المصادر، بالسياق السياسي ـ الإيديولوجي ذاته، فكان على العرب القفز من الإقطاع إلى الاشتراكية.
إن السياق السياسي هذا سيطر على المنهج وأخضعه لغاياته بدلاً من أن يكون بحثاً في الواقع والتشكيلات في مسارها العربي، وقد تم نقل المخطط التاريخي الخماسي القائل بوجود خمسة تشكيلات هي المشاعية، والعبودية، والإقطاع، والرأسمالية، والاشتراكية، ثم تم خرقه بالقول بضرورة القفز على التشكيلة الرأسمالية.
فهنا تغدو مقولاتُ المادية التاريخية غيرَ قادرةٍ على النفاذِ إلى البُنى الاجتماعية العربية، حيث تدعو للقفز من الإقطاع إلى (الاشتراكية) وفي هذا القفز إنكار للمادية التاريخية، فهنا أيضاً لا توجد أمة عربية ذات سيرورة تاريخية خاصة، بل موديلات جاهزة، أي أن المادية الجدلية لم تتحول إلى مادية تاريخية، لأن كلا الماديتين لم تتشكل في مادةٍ بحثية عربية.
هنا يقومُ الوعي بإسقاط ذاته على الواقع الموضوعي، فيتم خرق القوانين الموضوعية باسم ذات القوانين، فموضوعيةُ التشكيلات التي تُلقى تتحدد أساساً بعملية الانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية، فهاتان البنيتان بحاجة إلى درسٍ عميق، وحين تضيع قوانين كلا التشكيلتين لا يتشكل وعيٌ موضوعي.
إن (الأنا) تسقطُ معايير النفعية والفائدة المباشرة هنا ويقودُ هذا إلى عدمِ رؤية القوانين الموضوعية للمادة، سواء كانت طبيعية عبر العجز عن قراءة العلوم الطبيعية معرفياً، أو اجتماعية بالعجز عن اكتشاف قوانين تطور المادة الاجتماعية بسبب الإسقاط السياسي، فتتآكل الفلسفةُ المادية على جانبيها الجدلي والتاريخي، ومن هنا لا تغدو لها حفرياتٌ مميزة في الحياة الاجتماعية.
إن الإسقاط السياسي يقودُ إلى عدمِ قراءة سيرورة التشكيلات الحقيقية ويكون لهذا نتائجه بعدمِ رؤيةِ خيطِ التطور الموضوعي، مما يفتحُ الطريقَ للعودة إلى المثاليات.
إن تحولَ النظرية الموضوعية إلى أفكارٍ تستهدفُ منفعةَ الذات الجماعية، وليس إلى وعي جماعي يكتشف القوانين الاجتماعيةَ ويسيطر عليها، تقود إلى تآكل النظرية وتحولها إلى مجموعات من الشعارات والأفكار النفعية المتقلبة، وهو أمر يفتحُ البابَ لمجموعةٍ من المناهج المتناقضة المضطربة، من المادية الميكانيكية والجدلية مع اشكالٍ من المثالية الذاتية في خليطٍ يتجهُ في خاتمة المطاف إلى عدم الصمود ونفي تناقضاته الداخلية إلى مركب جديد.
فتسيطر فكرة نقل الموديل ولكن هذا الموديل غير صالح للسكة التاريخية التي يفترض أن يمشي عليها، إن المادية الميكانيكية هنا تتفكك وتتحطم، ففكرة إزالة الدين كما جرت في الاتحاد السوفيتي أو الصين التي تنُقل ميكانيكاً هنا تتحول إلى رفض كلي للدين، أو تتحول إلى استغلاله سياسياً، أي دون دراسته وفهمه واتخاذ مواقف دقيقة من عمق هذه الدراسات.
وتقود عمليةُ القفز على التشكيلة إلى القفز على مفرداتها الموضوعية كالدين والملكية الخاصة والرأسمالية ، أي تقود إلى عدم تنمية تطوير العناصر الديمقراطية الجنينية وتحويلها إلى انعطاف سياسي في البنية.
إن كفة التيارات السياسية العربية ستقوم بإعادة إنتاج هذه الطريقة سواء أكانت قومية أم بعثية أم دينية أم وطنية إقليمية شمولية أم قوى مذهبية سياسية.
إن إسقاط أهمية الرموز الدينية التي خلقت البنى الاجتماعية الإسلامية، يقود إلى عدم القدرة على تفكيك علاقة الإقطاع بالدين والتحكم في السلطتين السياسية والدينية، وبالتالي يقود إلى عدم القدرة على تكوين جبهات سياسية عريضة للتحول الديمقراطي .
فهذه الرموز نتاج تطور طويل للبنى، بحيث تغلغلت في مستوياتها السياسية الفكرية — الاجتماعية والاقتصادية، فهي تقوم بإعادة إنتاجها، ومن هنا يتطلب التغيير إعادة بنائها.
تتكونُ في التجربة (الشيوعية العربية) كما هي في التجربة القومية – البعثية والمذهبيات السياسية المختلفة، (الذات) المتجوهرة حول الطبقة القائدة التاريخية أو(الأمة) العربية أو(الأمة) الإسلامية أو الطائفة، وإذا كانت الذاتُ الشيوعية مرتبطةٍ بالواقع وعمليات تحليله الطبقة والتاريخية فإن المفهوم الذاتي الجوهري لا يتغير نوعياً، فهذه الذاتُ ستخرقُ قانونَ تحليل الواقع الموضوعي وستطرح برنامجها القادم من الذات العالمية المتجوهرة، ذات الطبقة العاملة العالمية، كما ستتمظهرُ فى كيان رأسمالية الدولة الشمولية في الاتحاد السوفيتي أو الصين الخ.. أي كما تتصور الطبقة العمالية، أقسامٌ من الفئات الوسطى تُسقطُ أفكارَها ومصالحها على حركة هذه الطبقة، أي تقوم بأدلجتها.
وسيدورُ العالمُ حول هذه الذات، ولهذا فإن درسَ التاريخ يغدو إسقاطاً منها عليه، فهى لا تقرأهُ بموضوعيةٍ بل تُسقطُ عليه برنامَجَها السياسي، فتغدو هي مركزه؛ بدلاً من أن تقرأهٌ مستقلاً عنها.
ومن هنا سيغدو تغيير الواقع المعاصر كذلك مرتبطاً بهذه الذات، فسترى تطبيق برنامجها هو الحقيقة الاجتماعية الموضوعية، أي كل ما يجعل الطبقة العاملة تسود، وهذا ما يكرسُ نموذجَ رأسمالية الدولة الشمولية كما في مصر والعراق والجزائر وسوريا واليمن (الجنوبية) الخ.. وبدلاً من برنامج الحياة الموضوعية وهو برنامج هدم النظام الإقطاعي الديني، وتشكيلِ نضالٍ طويل متدرج لتغييره، بتصعيد مختلف العناصر الديمقراطية والتحديثية، سيجري القفز على ذلك، وسيجري تقوية أجهزة الدول المركزية، وثقافة الشمولية المختلفة، وبقاء النظام التقليدي في خاتمة المطاف.
إن الذاتَ هنا غير قادرةٍ على إنتاجِ مقولاتٍ فلسفيةٍ بسببِ هذه المثالية الذاتية، المثالية المتقوقعةُ حول (الأنا)، ولهذا لا تستطيع أن تحل معضلات فهم التشكيلات التاريخية رغم اقترابها من درس الواقع الموضوعي بشكل كبير، لكن هذه الدرس يهدمهُ تصور ذاتي عن الوجود، وهو تصور (طبقي) يعود لفئات وسطى شمولية.
وكل التصورات البحثية والقومية والمذهبية السياسية صادرة عن مفهوم طبقي، ولكن هذه التصورات سترفض مفهوم الأنا الطبقي، وتحل محله مفهوم الأنا القومي أو الديني أو المذهبي، ومن الناحية التاريخية الكبرى، أي عبر المصير المتوقع في مسار التشكيلة، سيكون الأمر متقارباً، أي لن يكون ثمة فروق كلية بل فروق جزئية.
فالأنا القومية هنا كذلك تقومُ بإسقاط ذاتها على الوجود كما رأينا في آراء المفكرين القوميين، فالأنا العربيةُ تقفزُ خارجَ الزمان والمكان، ولهذا تغدو مقولاتها شعرية لا فلسفية، خطابية لا مفاهيمية موضوعية، ولهذا فإن الفئات الوسطى المنتجة لهذه الدعوات، ستتقاربُ مع الفئات الوسطى المنتجة للشيوعية العربية عبر تصعيد دور الدولة كجهازٍ تقني لحل معضلات القفزة الحضارية، نحو الحداثة، وإذا كانت الأنا القومية ستعملُ للحفاظ على جوهر الأمة وبقائها الميتافيزيقي، الخارج عن التاريخ، فإن الذاتَ الشيوعية العربية سترى تصعيدَ دور الدولة وتضخيم الطبقة العاملة مؤشرات نحو تحقيق الذات بشكل آخر.
إن الذاتين الشيوعية والقومية تتصادمان أو تترافقان عبر تصعيد دور الدولة المركزية وهو أمر يقودُ إلى تصعيد دور المنظومات التقليدية السياسية القديمة، أي تصعيد الدولتين السنية أو الشيعية الرابضتين تحت القشرة السياسية الهشة للحداثة، وهنا يجري القيام بطلاءٍ تحديثي، مترافق كذلك مع إنجازات اقتصادية واجتماعية تدفع ملايين من السكان للالتحاق بالتجربة، والتظاهر معها، ولكن نظام رأسمالية الدولة شكل انتقالي بين التشكيلات، وهو في الدول الشرقية المتخلفة، يغدو شكلاً انتقالياً بين تجديد نظام الإقطاع وتشكيل رأسمالية بأدوات بيروقراطية.
وهذا الأمر يتعلق بتجربة كل دولة وتقاليدها السياسية والاجتماعية، فالعراق توجه عبر البعث نحو استعادة نظام الإقطاع المذهبي بصورة قمعية شديدة، في حين اقتربت تجارب أخرى من الرأسمالية المُكونَّةً بشكلٍ إداري شمولي كمصر دون أن تخرج من نظام الإقطاع المذهبي بعد.
إن الفارق يتحدد بمدى ظهور فئات وسطى صناعية حرة، تبدأ في الحفر لتشكيل نظام رأسمالي حديث. أي بمدى القدرة على إنتاج وعي وطني ديمقراطي يتجاوز الشموليات بأنواعها: الشيوعية، القومية التعصبية، المذهبية والدينية التقليدية الخ.
وبهذا فإن المذهبَ السائد وسيطرة الارستقراطية والذكور والشمولية السياسية والفكرية كلها يُعاد إنتاجها، وسيغدو المذهب الديني السياسي المهيمن الشكل الإيديولوجي للخروج من الأزمة الفكرية الناتجة عن فشل الطريق (الاشتراكي) المزعوم.
أي أن القوى المسيطرةَ على الجهاز السياسي والاقتصادي والعسكري الشمولي تواصل تاريخ الاستغلال السابق، لكنها في الدول العربية والإسلامية لم تستطع الخروج من التشكيلة الإقطاعية، فظلت أسئلةُ الحداثة حارقةٍ في جسمها السياسى والاجتماعى.
إن هذه أيضاً عدم قراءة موضوعية وتطبيقية لـ(القوانين)، فقوانين المادية الجدلية بقراءة الطبيعة تخرق على مستوى قراءة تطور المجتمع، فتنفك العلاقة بين جدل الطبيعة وجدل التاريخ، ويغدو المجتمع مرهوناً بمخطط ذاتي لدى القيادات، فتحل الإرادةُ الفرديةُ نفسها محل القوانين الموضوعية للصراع الاجتماعي، وتهيمنُ الأرادةُ الفوقية على الأحزاب؛ وتهيمنُ على الدول، وعلى الملكية العامة المُصادرة، فتتشكل فئاتٌ بيروقراطية استقلالية، تهدرُ الثروةَ العامة.
وبدلاً من تصعيد فئات وسطى وعاملة حديثة ديمقراطية، يقوم الهيكلُ البيروقراطي بنخر الحداثة الاجتماعية الضعيفة، وبدلاً من تصعيد فردية وتحررية اجتماعية وعقلانية، يتم القفز إلى هياكل إيديولوجية عامة فارغة، مثل (ضرورة هدم الطبقات) أو (هدم الأديان)، لكن في المحتوى الاجتماعي العميق تبقى الذكورية المتسيدة والقبلية والبيروقراطية المتحكمة في الثروة والأطر الإقطاعية المذهبية.
ويصل نظام رأسمالية الدولة الشمولية الشرقي إلى أزمته، فتتفكك المنظومة، وتوابعها داخل المعسكر (الاشتراكى) أو خارجه. مثلما تحدث أزمة الأنظمة الأخرى العربية المحافظة ذات الجوهر (الستاليني)؛ ملكية عامة بيروقراطية مسيطر؛ وهي فاسدة.
وقد لعبت التحولاتُ الاقتصادية النفطية دورها في تصعيد قوى الإقطاع المذهبية بشكل أكبر من السابق، وبدلاً من تصعيد دور الرأسمالية (الحرة) انتشرت القوى التقليدية والشمولية القديمة. فهذه التحولات جرت في البلدان الصحراوية والريفية متدنية التطور، فساهمت في تأخير المدن العربية السائرة سابقاً في طريق التطور الحديث. وهكذا فإن أنظمة الإقطاع المذهبية حصلت على دفعة قوية.
هذا أدى إلى صدمة لمركزية الذات الشيوعية والقومية، فالتصور السائد بحدوث القفزة، انقلب إلى حدوث الارتداد، وهو أمر قاد إلى تآكل الوعي والتنظيمات وأعطى دفعة للصعود المحافظ كذلك.
فإذا كان مثل هذا الوعي لم يستطع أن يصلَ إلى فهمِ أساسيات التاريخ، ووضع إرادته الذاتية بديلاً عنها، فإن الطوابقِ التحتية في ذاته مليئه بأشكال الغيبيات والمثالية، ولهذا فإنه حتى مفاهيم المثالية الموضوعية التي لم تتشكل هياكلها لم تستطع الحضور النقدي الاجتماعي، ولهذا فإن شتى أشكال المثاليات الذاتية تتفاقم وتتصاعد في مرحلة الانهيار
والاضطراب.
فمع مرحلة انهيار أسلوب ملكية الدولة المركزية الشمولية، على الصعيد العربي بسقوط الأنظمة الوطنية ذات الملكية العامة السائدة، أو بأزمات الأنظمة العربية المحافظة، تصاعدت موجةُ المذاهب النصوصية، كتعبير عن غياب بحث وتجسيد القانون نظرياً واجتماعياً.
فتصاعدُ الغيبيات المتطرفة كانتشار خرافات القبور وتحضير الأرواح الخ..
كان إعلاناً عن هجمة المناطق الرعوية والريفية، وبلدان الجزيرة العربية الصحراوية على المدن، النهضوية المتآكلة، وظهور زمن الثروة اللاقانوني، المستند إلى الصدف المحضة، وهكذا فزمن النهضة الأول المستند إلى اكتشاف وتجسيد القانون والصناعة الشخصية، تم القفز عليه عبر الانقلابات العسكرية ثم المناطقية المحافظة، وبهذا فإن الحكام المطلقين ظلوا في السلطة الأرضية كما ظلت صور الإله المطلقة الخارقة للقانون، أي أن الثروات وتوزيعها ظلت لدى أهل السلطة المتحولين والناتجين من تبدلات سياسية خارج الوعي والإرادة البشرية، وبهذا فإن النصوصيات الدينية المعادية للعقل صعدت بقوة، بدلاً من تراكم الفكر الموضوعي والعلوم.
إن الأفكار الدينية النصوصية المحافظة تقوم على صور الإله المتدخلة في كل شيء، تعبيراً عن ضعف الإرادة البشرية الشعبية تجاه التسلط الديني والحكومي، فتتوارى سببيات الثروة والأمراض والحروب وتدهور المدن الخ. . ويغدو كل شيء بـ(بإذن الله+ وأنشاء الله) وليس بإرادة العصابات الحاكمة في الحكم والدين.
وهذا يوسع انتشار اللاعقلانيات والغيبيات المتطرفة والصوفيات، وينهض الموتى للتحكم في الأحياء، وتسيطر الأرواحُ على الأجساد المفرغة من العقول. ويدير اللصوص المسرحين السياسي والاجتماعي.
التطور الفلسفي العربي الحديث المبكر
إذا أخذنا سلسلةَ التطورات التي حدثت خلال القرنين الأخيرين ، فسنجد ثلاثة فترات كبرى: الأولى تمثلت في استيعاب المنجزات الغربية ، الثانية : في تشكيل تجارب لرأسمالية دولة شمولية، توهمت إمكانية تجاوز العصر الرأسمالي، الثالثة عودة متدهورة للفترة الليبرالية الأولى مع عودة كذلك للإقطاعين السياسي والديني الشموليين.
كان النهضويون الأوائل في القرنين الــ 19 والــ 20 يتصورون أن التماثل مع الغرب هو كفيل بخلق النهضة، وحين تزعزع هذا الوهم راح الدينيون يتصورون وهماً آخر هو استرجاع الفترة الأولى من العصر الإسلامى.
أي أن دراسة العصرين العربيين السابقين ورؤية تضادهما والخروج بتركيب منهما، وفي ظل ثقافة الحداثة المسيطرة، كان يمكن أن يكشف للعقول قوانين التطور الاجتماعي، وبالتالي يؤدي إلى التحكم فيها.
إن عصرنا العربي الإسلامي الراهن هو عصر التركيب، للعصرين العربيين السابقين، تداخل معهما ونفي لهما معاً. إنه عصر نفي النفي. وهو لهذا عصر التمثل العميق للحداثة العربية على مر الزمن والصعود بها إلى لحظة نوعية جديدة مقاربة لمستوياتها العالمية.
فأخذ إنجازات الثورة المحمدية، والجوانب الإيجابية من نضال الفئات الوسطى التحديثية في العصر النهضوي الأموي – العباسي السابق، وتشكيل نضال نهضوي للفئات الوسطى المتحالفة مع العاملين بشروط الحداثة المعاصرة.
وهكذا فإن إنجازات التحالف الشعبي الديمقراطي الإسلامي النهضوي الجريء في اقتحامه العالم، يضاف إلى تراكمية الثقافة الفكرية الموسوعية والانفتاح وعقلنة الفقه وعصرنته، وقد تم كل ذلك بوعي ديني مثالي مسيطر على أجهزة الحكم، تعبيراً عن القوى العليا مرة في تحالفها مع العاملين ومرة في انقطاعها عن التحالف مع العاملين.
وبهذا فإن طيفاً اجتماعياً واسعاً لابد أن يتشكل ليعيد إنتاج الحضارة العربية المستقلة الحديثة، وهذا التحالف الذي في جوهره تحالف الفئات الوسطى والعاملين، له مضمون اجتماعي هو إعادة تغيير طابع الدولة، في ملكيتها الاقتصادية الشاملة، وفي مذهبيتها السائدة المتحكمة، وفي تحرير كافة هذه الجموع من الدولة الإقطاعية – المذهبية، وفي خلق طبقات وسطى وطبقات عاملة حرة، تتداول السلطة حسب برامجها المقبولة للجمهور.
وعملية إجراء الإصلاحات في جسم الدولة – المجتمع الاقتصادي والديني والاجتماعي والسياسي، يعتمدُ على سلسلة من الإصلاحات في ظاهرات الوعي المختلفة.
إن جسم الدولة – المجتمع الذي يعيش النظام الإقطاعي المذهبي، يعيش المفردات الدينية الشمولية، كخلفية متحكمة فيه عبر القرون.
وإذا كانت صورة الإله الواحد المتدخلة في كل شيء التي زرعتها الأنظمة الاستغلالية فتلك صناعة الحاكم الواحد الذي يهيمن على السلطة – المجتمع زاعماً أنه شبه إله!
وقد قامت الفلسفات في العصر الوسيط الإسلامي بخلق وسائط غيبية متعددة في المشرق الإسلامي، ثم في المغرب أخذت نتخلصُ من هذه الوسائط بحيث غدت فلسفة ابن باجة — ابن رشد تشق الطريق نحو مثالية موضوعية.
لقد استغرقت العملية بين التكوين الديني الصوري القصصي الميثولوجي الحكمي، وبين تكون الفلسفة المثالية بمعمارها التعددي المفاهيمي عدة قرون، ثم إلى أن تكون مثالية موضوعية جنينية في الأندلس على بضعة قرون أخرى. وهذه المثالية الموضوعية الجنينية ترحلت إلى أوروبا لتبدأ رحلة جديدة في بُنى اجتماعية مختلفة مشكلة الرشدية المقاتلة المرفوضة من قبل الكنيسة ولكن التي وضعت الأساس لهدم هذه الكنيسة الشمولي.
فكأن الانتصار العربي الإسلامي في أوروبا!
وحين وصلت الفلسفةُ من أوروبا إلى العالم الإسلامي محملةٍ بكل هذا الزخم التحولي المتضافر الداخلي، فإنها لم تُفهم من قبل الجيل الأدبي، جيل التنوير الأول؛ فقد كان تاريخ أوروبا الوسيط والنهضوي والمعاصر معروضاً أمامه، بشكلٍ غامض، بحيثيات سياسية واجتماعية واقتصادية وفكرية، فكانت الوقائع الاجتماعية المباشرة كمظاهر التقدم في مختلف جوانب الحياة هي الطافحة على سطح الوعي النخبوي، وهذا ما كان يمثل له صدمة على صعيد أنه كان عبر موروثه يعتبرُ نفسَه محورَ العالم والبقعةَ الأكثرَ حضارةٍ فيها، ودينه يمثل أرقى تكون فكري عرفه الإنسان.
ومن هنا كان وعيه ينقلُ وقائعَ الحياة والثقافة بعناصرها المشتتة متقبلاً المظاهر الحديثة الأكثر وظيفيةٍ ونفعيةٍ والتي تغدو عبر التجارة مستخدمةٍ في حياته، محتفظاً ببنائه التقليدي المحافظ، حيث يعبرُ هذا الاحتفاظ عن جانبي الاستخدام الوظيفي وبقاء أسس النظام التقليدي التي تسيطر عليه القوى العليا، ومهما كانت التغيرات السياسية التبدلية في هذه القمة فإنها لم تغير هذا البناء، إن لم تحافظ عليه بقوة أشد.
من هنا كان الوعي التنويري أدبياً ثقافياً تقنياً عاماً، لا يستطيع أن يطرح المنظور الفلسفي، وأن يشكل نظرات عامة إلى الوجود، حيث ان وجوده الاجتماعي هو ذاته مقلق وغير مفهوم.
فكان عليه أن يعي أساسيات وجوده الوطني أولاً، أي أن يقوم بخلقِ لحمةٍ في بنائه السياسي التابع والمتخلف، وهو أمرٌ يجعل البنى العربية والإسلامية المفتتة تقومُ ولهذا فإن الاحتكاك بأوروبا كان يتيحُ استخدام بعض الأسس السياسية الاجتماعية الأوروبية في العمل لتشكيل هذه البنى، وكل بنية عربية وإسلامية لها ظروفها وسيرورتها الخاصة، والمتداخلة مع السيرورات الأخرى كذلك.
إذن كان الوعى وهو يشكلُ البنية التقليدية – المحدثة، يمر بمرحلة التأثر الأوروبى – والعودة إلى الماضي، عبر استخدام مفهوم النهضة، وهو الذي كان يتيح استعارة الأشكال الأوروبية وتركيبها فوق الجسد القديم، مع الزعم بأنه يتحدث، فهو يغرف من الماضي المجيد، وكذلك يستفيد من الخبرة الأوروبية، التي كانت (وليدة التأثير العربي).
ولكن لم يكن يدرس هذا التداخل العربي – الغربي في سيرورته التاريخية المعقدة والمتوارية، أي أن يدرس رحلة المثالية الموضوعية وتبدلاتها العميقة في أوروبا، من الرشدية المُلاحقة إلى الديكارتية المنفصلة كثيراً عن تقاليد الفلسفة الدينية للعصر الوسيط.
إن ثمة عدة قرون أخرى بين الرشدية الملاحقة وبين الديكارتية، وهذه السيرورة لن تُدرس عبر هذا الوعي الأدبي – الفني وهو يقابل أمثاله في الإنتاجين الأوروبي والعربي القديم، لكن هذا الدرس المتعدد الأشكال سوف يضع مادة ثقافية كبيرة للمرحلة التالية وهي مرحلة الوعي الفلسفي.
وهناك عناصرٌ فلسفية مشتتة في داخل هذه المرحلة، فكان التأكيد على الخلق الإلهي للعالم، يتداخل مع الإيمان بالضرورات الموضوعية للوجود، وهو أمر يشير إلى هذه الثنائية بين الجذور المتواصلة الحضور، أي بين النظام المحافظ بألوهيته المطلقة، وبحكامه المطلقين، وببنائه الاجتماعي الذكوري – الأرستقراطي وثقافته السحرية – الدينية، وبين ضرورات التحديث التقنية.
فكان التقنيون فوق الجسد المحافظ يستوردون المنجزات البنائية والتقنية والأدبية والديكورية الخ.. إن فكرة الخلق الإلهي والسببية المحدودة، تتماثل وعملية التداخل العربي – الغربي في مرحلة الاستعمار والتجارة وإنتاج المواد الخام، فهما تتيحان الحفاظ على النظام التقليدي بأسسه الدينية، وأيضاً تطوير بعض الجوانب في الحياة الأكثر إلحاحاً كتغيير الحرف ونمط المدن والإدارة ونظم التعليم الخ.. لكن عمليات التغيير تتجه إلى جوانب أكثر عمقاً بطبيعة تطور الحياة، وسواء بسبب من اهتراء القديم، أم من هجوم الجديد، وهذا يمكن ملاحظته في تعمق الأشكال الأدبية كالقصة والرواية والمسرح، وتوجهها نحو عمليات تحليل الواقع بصورٍ متزايدة، وكذلك عمليات اتساع العلوم ونمو تخصصاتها، والتبدل المستمر بين حجم الزراعة وحجم الصناعة، واستعادة المدن العربيةِ دورها النهضوي، وبدء إلحاق الريف والبادية بتحولاتها.
ومن هنا فالسببية سوف تتزايد عملياتها في الوعي، وتصبح الظواهرُ المشتتة في الوعى التنويري الأولي أكثر ترابطاً؛ فلم تعد العملية استلال عنصر وحيد من التراث، أو من الغرب، بل أخذت عمليات النظرة التركيبية بين الثقافة والوجود الاجتماعي والتاريخي، تتشكل في العقل النهضوي الجديد، وأصبح العالم العربي الإسلامي بتطوراته الكبرى مرئياً في هذا العقل، ولكن في ظاهراته الفكرية الروحية المستقلة عن البنى الاجتماعية التي يتشكل فيها.
يمكن هنا أن تتشكل لمحاتٌ من العرض الاجتماعي، لكن الوعي يظل مستقلاً، وبه سبيياته الداخلية المترابطة الأعمق، والمنفصلة عن البنى الاجتماعية.
هنا علينا أن ندرس الصراع بين المثالية الموضوعية الدينية والمادية الجدلية، كتعبير عن طفولية الوعي الفلسفي في الجانبين. من جانب عجز المثالية الموضوعية عن النمو وكشف الواقع، وقفزة المادية الجدلية للريادة الكشفية، وإخفاقها في ذلك، عبر حدوث فجوة كبيرة بين المادية الجدلية والمادية التاريخية.



