محمد إلهامي's Blog, page 12
March 6, 2021
فائدة التاريخ في حفظ الدين
كان حفظ الدين هو الغاية الأولى التي نشأ لأجلها علم التاريخ في الإسلام، ومنه نشأت علومٌ جمَّةٌ في القرآن والسنة كالناسخ والمنسوخ الذي نعرف به كيف تدرج شأن الشريعة وأحكامها، وعلم الرجال والجرح والتعديل الذي حُفِظت به السنة، فضلا عن سائر ما نعرفه عن السيرة والمغازي والفتوح الذي هو صلب موضوع التاريخ، وبه صارت سيرة النبي ثم سيرة أصحابه أصحُّ سيرة لرجل في التاريخ، إذ نُقلت إشاراته وحركاته وبسماته وصفة صلاته وحجه على أدق ما هو ممكن.
لهذا قال خليفة بن خياط (ت 240هـ) في أول عبارة في تاريخه "هذا كتاب التاريخ، وبالتاريخ عَرَفَ الناسُ أمْرَ حجِّهِم وصومِهم وانقضاء عِدَدِ نسائهم ومحلّ ديونهم"، وقال الطبري (ت 310هـ) في مطلع كتابه "ليَصِلوا بذلك إلى العلم بأوقات فروضهم التي فرضها عليهم في ساعات الليل والنهار والشهور والسنين من الصلوات والزكوات والحج والصيام وغير ذلك من فروضهم وحين حلّ ديونهم وحقوقهم"، ولما أفرد الصفدي (764هـ) فصلا لفوائد التاريخ لم يأت فيه بغير أمثلة من التزييف المؤثر في حفظ الدين لولا أن استعمل العلماء التاريخَ لكشفه ودحضه، ووضع السخاوي (ت 902هـ) تعريفه للتاريخ على أنه "الوقت الذي تُضْبَط به الأحوال من مولد الرواة والأئمة، ووفاةٍ وصحةٍ وعقلٍ وبدنٍ ورحلةٍ وحجٍّ وحفظٍ وضبطٍ وتوثيقٍ وتجريحٍ، وما أشبه هذا مما مرجعه الفحص عن أحوالهم في ابتدائهم وحالهم واستقبالهم ويلتحق به ما يتفق من الحوادث والوقائع الجليلة"، ونلاحظ في تعريف السخاوي أنه اهتم بتواريخ الرواة قبل اهتمامه بالحوادث التاريخية، كما أنه حين تحدث عن فائدة التاريخ ذَكَرَ أوَّلَ ما ذَكَر "معرفة الأمور على وجهها، ومن أجلِّ فوائده: أنه أحد الطرق التي يُعلم بها النسخ في أحد الخبرين المتعارضين المتعذر الجمع بينهما"، وضرب العديد من الأمثلة.
من هنا يظهر مقصد المسلمين في التاريخ، وأن أول مقاصده فهم الدين وضبطه وحفظه، ولا يفهم أكثر المؤرخين المعاصرين هذا المعنى، إذ يحسبون أن هذا المجال إنما هو مجال بحثٍ دينيٍّ فحسب، بل ربما أدانوه واعتبروا أنه نوعُ تحقيرٍ للتاريخ عند علماء المسلمين وتضييق لمجاله، وليس الأمر كذلك، ولكن هؤلاء غفلوا عن معنى التاريخ عند المسلمين وعن فائدته في حفظ الدين.
وقد حقق المسلمون هذا المقصد، واستثمروا هذه الفائدة على خير وجه، بل لم تصل أمةٌ من الأمم لمثل ما وصلوا إليه من الحفظ والضبط والدقة، إذ هذه العلوم التي استقلَّتْ -كعلم الرجال والطبقات والعلل والجرح والتعديل- لم توجد عند أمة أخرى، وبذلك كان مجمل التاريخ الإسلامي أصح التواريخ الإنسانية، ولا سيما صدره الأول الذي هو زمن النبوة والخلافة الراشدة والقرون الأولى، إذ تاريخ الصدر الأول هو من الدين، فنحن أمة بعض دينها تاريخ وبعض تاريخها دين! وسنعود إلى الكلام عن أثر هذا الأمر في نشأة وتطور علم التاريخ لدى المسلمين فيما بعد.
ولقد بدأت محاولات تزوير التاريخ للطعن في الدين مبكرا منذ صدر الإسلام، وهي مستمرة حتى اليوم، وكثيرا ما كانت الوسيلة المباشرة لكشف هذه المحاولات والتصدي لها هي معرفة التاريخ كما قال سفيان الثوري: "لما استعمل الرواةُ الكذبَ استعملنا لهم التاريخ"وكما قال حماد بن زيد: "لم يُسْتَعَن على الكَذَّابين بمثل التاريخ"، ومن أمثلة ذلك:
1. أن روايا اسمه أبو المعلى بن عرفان روى في مجلس أبي نعيم رواية عن معركة صفين لفَّق لها إسنادًا، فقال فيها: "خرج علينا ابن مسعود بصفين" فقال أبو نعيم: "أتراه بعث بعد الموت؟!"، وذلك لأن ابن مسعود توفي في خلافة عثمان قبل معركة صفين، فانكشف بذلك كذبه.
2. زَوَّرَ يهودٌ من أحفاد يهود خيبر وثيقة على النبي تقول بأنه يعفيهم من الجزية، وجاءوا بها إلى الوزير أبي القاسم بن مسلمة، فاستدعى الوزيرُ الحافظَ الخطيبَ البغدادي فنظر فيه "فقال: هذا كذب، فقال له: وما الدليل على كذبه؟ فقال: لأن فيه شهادة معاوية بن أبي سفيان ولم يكن أسلم يوم خيبر، وقد كانت خيبر في سنة سبع من الهجرة، وإنما أسلم معاوية يوم الفتح، وفيه شهادة سعد بن معاذ، وقد مات قبل خيبر عام الخندق سنة خمس".
3. زعم المستشرق اليهودي الشهير إجناس جولدزيهر أن حديث "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد" إنما هو من وضع الإمام الزهري، وأنه وضعه لرغبة عبد الملك بن مروان في صرف الناس عن عبد الله بن الزبير ضمن الصراع المحتدم بينهما، إذ كان عبد الملك يحكم الشام وفيها بيت المقدس وكان ابن الزبير يحكم مكة. وقد ردَّ عليه العلماء المعاصرون بأن الزهري لم يلق عبد الملك إلا (80 أو 82هـ) أي بعدما انتهى الصراع بينه وبين ابن الزبير، مما يثبت بجلاءٍ كذبَ جولدزيهر وتزويره.
4. زعم نصر حامد أبو زيد أن الشافعي إنما كان متعصبا للعرب والعربية، وهذه خلاصة مشروعه العلمي الذي أراد به التأسيس للعصبيةِ العربيةِ ورأيِ أهل الحديث ضد أهلِ الرأي، وكان من ضمن ما قاله نصر أبو زيد أن الشافعي كان متعاونا مع الدولة الأموية المتعصبة للعرب. ولما ردَّ عليه الباحثون المعاصرون ذكَّروه بأن الشافعي وُلِد بعد انهيار الدولة الأموية بثمانية عشر عاما.
إن بعض الأمور تكون أخفى من هذا وتحتاج فحصا وصبرا، مثلما فعل د. إبراهيم عوض حين أثبت سرقة طه حسين فكرته عن الشعر الجاهلي من المستشرق صمويل مرجليوث، فقد تتبع د. إبراهيم إنتاج طه حسين وتناوله لمسألة الشعر الجاهلي فيه، وأثبت أن التحوّل في رأيه لم يحدث إلا بعد صدور دراسة مرجليوث، وكانت مسألة الشعر الجاهلي مدخلا لمرجليوث ثم لطه حسين للتشكيك في القرآن، لأنهما زعما أن المسلمين اخترعوا الشعر الجاهلي ونحلوه لأسماء الشعراء الجاهليين.
وبعض الأمور تكون مفضوحة للغاية، مثلما فعل إعلامي مصري قبل سنين قليلة من الزعم بأن جماعة الإخوان المسلمين هم من أسقطوا الأندلس!!! فأهدر بذلك أربعة قرون بين الأندلس وبين نشأة الجماعة!
والخلاصة المقصودة أن الفائدة الأولى لعلم التاريخ كما نشأ ونما في الإسلام كانت حفظ الدين ونقله بالعناية والضبط والدقة التامة، ومن ثَمَّ كان التزوير في تاريخ الإسلام عسيرا ومفضوحا.نشر في مجلة المجتمع الكويتية، مارس 2021
خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، تحقيق: د. أكرم العمري، ط2 (دمشق – بيروت: مؤسسة الرسالة، 1397هـ)، ص49.
الطبري، تاريخ الطبري، ط1 (بيروت: دار الكتب العلمية، 1407هـ)، 1/12.
الصفدي، الوافي بالوفيات، 1/55، 56.
السخاوي، الإعلان بالتوبيخ، ص18.
السخاوي، الإعلان بالتوبيخ، ص19.
انظر مثلا: حسين مؤنس، التاريخ والمؤرخون، ص29، 30، 35؛ وجاء مثل ذلك في مقدمة روزنثال للسخاوي (ص8) وهو منه غريب لأن روزنثال فضلا عن رسوخه وسعة علمه فقد كان منتبها للمقصد الديني للتاريخ عند المسلمين وسجَّله بوضوح، وأغلب ظني أن روزنثال تفطن لهذا المقصد أثناء تأليفه كتابه "علم التاريخ عند المسلمين" وليس قبل ذلك، لذا صرَّح به في مواطن وصرَّح –أو ألمح- بعكسه في مواطن عديدة أحسبه لم ينتبه لإصلاحها جميعا.
انظر: ابن حزم، رسالة في مراتب العلوم، ضمن: رسائل ابن حزم، 4/74، 75.
ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال، 1/169.
الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، تحقيق: د. بشار عواد معروف، ط1 (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 2002م)، 8/339. وفيه أن القائل "حسان بن زيد"، وأغلب الظن أنه "حماد بن زيد" لأمور يضيق المقام عن بيانها.
للمزيد من الأمثلة، انظر: السخاوي، الإعلان بالتوبيخ، ص19 وما بعدها.
صحيح مسلم، المقدمة، 1/26.
ابن كثير، البداية والنهاية، تحقيق: علي شيري، ط1 (بيروت: دار إحياء التراث، 1988م)، 12/124.
مصطفى السباعي، السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، ط1 (دمشق: المكتب الإسلامي، 2000م)، ص245؛ محمد مصطفى الأعظمي، منهج النقد عند المحدثين، (مكتبة الكوثر، 1990م)، ص127 وما بعدها.
محمد جلال كشك، قراءة في فكر التبعية، ط1 (القاهرة: مكتبة التراث الإسلامي، 1994م)، ص198 وما بعدها.
د. إبراهيم عوض، نظرية طه حسين في الشعر الجاهلي سرقة أم ملكية صحيحة، نسخة إلكترونية، على الرابط:
February 14, 2021
تزكية د. سيف الدين عبد الفتاح

كنتُ قد عرضتُ بحثي "فحص دعوى أثر السياسة في تدوين موطأ مالك" على الأستاذ الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، فقرأه متفضلا، ثم كتب على صدره هذه الكلمات:
"هذا البحث خطة عملية ونموذج عملي وبحثي لتطبيق المنهج لردّ دعوى التأثير بأثر السياسة في تدوين الموطأ.
بارك الله فيكم وفي منهجكم وعلمكم"
February 13, 2021
خواطر حول فكرة تحديد فترة الرئاسة في النظام الديمقراطي
بسم الله..
من مبادئ الديمقراطية المعاصرة تحديد مدة تولي السلطة، بحيث يُنتخب الرئيس لعدد من السنوات، يمكن أن تجدد لفترة واحدة إضافية فقط. والغرض من ذلك: ألا تطول مدة بقاء الحاكم في السلطة فيحمله هذا على الطغيان والاستبداد والتحول إلى فرعون جديد.
هذه الصورة هي جزء من الأنظمة الرئاسية، بينما النظام البرلماني الذي يضع السلطة في يد رئيس الحكومة لا يضع هذا القيدَ عادةً، إذ يمكن للحزب الفائز في الانتخابات أن يتولى السلطة بنفس شخص مرشحه لمدة غير محددة. (مثال: نتنياهو يتولى رئاسة الحكومة منذ 2009 حتى الآن، أي 12 عاما متواصلة)
السؤال هنا: هل أدى هذا الوضع إلى خفوت الديكتاتورية أم إلى اختبائها فيما يُسَمَّى "الدولة العميقة"؟
الإجابة: انظر هذا المنشور: https://www.facebook.com/mohammad.elh...
لكن حديثنا الآن له غرض آخر.. ولكن اصبر معي قليلا..
لقد جاءتنا هذه الفكرة، فكرة تحديد مدة السلطة، ضمن الموجة الغربية المستمرة منذ قرنين من الزمن، وسُئِل المسلمون: ما موقفكم من تحديد مدة تولي السلطة؟
وهذا السؤال حين يُطْرَح من قِبَل المنتصر -أو المنبهر بالمنتصر- على المهزوم المغلوب، فإنه يكون سؤال مُحَمَّلًا بقوة المنتصر وسطوته، وتكون إجابته مُحَمَّلَةً بضعف المغلوب وذِلَّتِه.
[كمثال على الهامش: كانت الدولة العثمانية في أوج قوتها، مطلع القرن السابع عشر، حين كانت تحارب الكومنولث البولندي الليتواني، وكان تجربة ديمقراطية مبكرة في أوروبا، حيث يتربع ملك منتخب على عرش نظام قوامه البرلمان المركزي والمجالس المحلية.. فلم ير العثمانيون أنهم بحاجة إلى الديمقراطية، بل رأى البولنديون بعد الهزائم أمام العثمانيين أن هذا النظام البرلماني يعطل المبادرة ويثبط القرارات الجسورة.. ولأن التجربة لم تستمر طويلا، فلم تكن ذات إغراء ولا بريق لأحد في الجوار، لا الروس ولا العثمانيين ولا الأوربيين]
والفقه السياسي عند المسلمين، يُسْتَمَدُّ في هذه المسائل من عصر الخلافة الراشدة، وبالنظر إلى ذلك العصر سنجد أن الخلفاء الأربعة بقوا في السلطة حتى وفاتهم، ولم يُطْرَح عليهم ولا طرحوا هم فكرة المدة الزمنية.
فذهبت طائفة من العلماء المعاصرين إلى أن الإسلام ليست فيه فكرة تحديد المدة الزمنية للسلطة.
وذهبت طائفة أخرى إلى القول بأن هذه الفكرة جائزة اعتمادا على أن عدم فِعْل الخلفاء الراشدين لشئ لا يدل على تحريمه، ولم يرد عنهم النهي عن ذلك، فهي فكرة واقعة في دائرة النظر وتقدير المصالح والمفاسد. وإذا تحققنا أن ثمة مفسدة في إطلاق المدة الزمنية للحاكم، فيكون من الجائز تقييد المدة وتأقيت عقد السلطة، قياسا على أن الإمامة عقد كسائر العقود، وهي عقد وكالة بين الأمة والأمير، وإذا جاز في العقود عموما وفي عقد الوكالة خصوصا فكرة التأقيت فإنه يجوز أن يكون ذلك في عقد الإمامة.
وليس من غرض المنشور الدخول في هذا السجال الفقهي ولا الفصل فيه، ولكن لا بد من إيضاح أمور:
- أن كلا الفريقين يتفق على أن الحاكم الشرعي يُوَلَّى برضا الأمة، وللأمة حق مراقبته ونصحه، ولها حق عزله والقيام عليه إذا أفسد وجار وانحرف، مع مراعاة المفاسد والمصالح المترتبة على عملية الخروج كتنزيل عملي لحق العزل في الحالة المُعَيَّنة التي يقدرها أهل العصر.
- أن كلا الفريقين يتفق، من خلال فقه الخلافة الراشدة نفسه، أن عزل الأمير غير مرتبط بوقت وإنما مرتبط بسياسته وسلوكه، فمن حق الأمة عزل الأمير بعد عام أو عامين أو ثلاثة وليس في الفقه ما يشترط على الامة الانتظار أربعة أعوام أو خمسة -كفترة أولى- قبل أن تفكر في الاعتراض أو أن تُقْدِم على خلع الأمير.. وهذا الأمر واضح من خُطَب الخلفاء الراشدين التي بدؤوا بها ولاياتهم، كقول أبي بكر "فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم".
- أن كلا الفريقين يتفق على أن من واجب الأمة اختيار الأفضل للولاية، دون مراعاة المجاملات والروابط والعصبيات، بل يُقَدَّم للولاية من هو أولى بها وأحق.
ولو دققنا في هذه النقطة الأخيرة، لفهمنا لماذا لم يفكر علماؤنا الأقدمون في مسألة تأقيت عقد السلطة، إذ إن تولية الأفضل والأحق بالمنصب سيجعل من مقتضى هذا ولوازمه أنه لا يُعْزَل هذا الأفضل ويُؤتَى بغيره إلا لو وقع منه أو له ما يجعله غير كفء ولا جدير بالولاية، سواء لفساد طرأ عليه في دينه أو جسمه.
وقبل أن نغادر هذا الجزء، يجب القول بأن النظام الاجتماعي الإسلامي يذهب إلى بناء مجتمع قوي، وسلطة محدودة الصلاحيات، وهو حافل بالتشريعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تجعل عملية اختيار الحاكم جزءا واحدا من منظومة أشمل، تكون معها صلاحيات الحاكم أقل كثيرا من صلاحيات أي حاكم ديمقراطي معاصر
وللتفصيل في هذه الفقرة الأخيرة انظر هذه الروابط:https://www.youtube.com/watch?v=ikfGG...
***
دعونا نُرَكِّز النظر الآن على العلماء وعلى الحركات الإسلامية، الذين قبلوا بهذه الفكرة، فكرة تحديد مدة السلطة والولاية، وقبلوا بفكرة الانتخابات، وجعلوها ضمن لوائحهم في جماعاتهم وفي مؤسساتهم العلمية.
وهؤلاء لا يمكن الحديث عن أن قبولهم بهذه الفكرة هو محض نظر وتفكير علمي، بل إن في قبولهم به تأثرا واضحا بالثقافة الغربية الغالبة والبرّاقة، وفيه أيضا نفورهم من نتائج الطغيان والاستبداد الذي يشمل العالم الإسلامي، فالمواقف لا تُتَّخَذ في الفراغ، وإنما هي حصيلة الظروف والمشكلات الواقعية.
بحسب ما أعلم، فإن الزعماء المؤسسين للحركات الإسلامية وللمؤسسات العلمية ظلوا حتى نهاية عمرهم، أو حتى لحظة عجزهم، في موضع القيادة، وإذا حصل نوع من الانتخابات في جماعتهم فإنه يُجَدَّد لهم لمدة أو لمُدَدٍ أخرى في مناصبهم.. فإذا جاءتهم الوفاة أو جاءهم العجز عن القيام بالمهمة، كانت توصيتهم باسم من يخلفه في المنصب توصية نافذة، وتأتي عملية الانتخابات الشكلية كاستجابة لرغبة الزعيم أو القائد.
ونستطيع أن نعدَّ من خرجوا على هذا النسق وأصروا على الاستقالة في حال قدرتهم كحالة شاذة، مثل مهدي عاكف في حالة إخوان مصر أو خالد مشعل في حركته.
والآن سيكون لدينا احتمالان لتفسير هذا الموقف؛
الأول: إما أن هذه الحركات والمؤسسات العلمية أصابها النفاق أو أصابها الفساد، فهي تعلن شيئا وتمارس عكسه.
والثاني: أن هذه الحركات والمؤسسات رأت من خلال الممارسة العملية أن عملية الانتخاب لا تأتي بالعناصر الصالحة للقيادة والعمل، فهم يتحايلون على هذه العملية بما تيسَّر لهم من الحيل.
ولا مانع أن يكون واقع الحال خليطا من هذا وذاك، شيئا من هنا وشيئا من هناك.
ولمرة أخرى، لن ندخل في هذا الجدل، ولكن: ألا تتفقون معي في أن هؤلاء العلماء وهذه الحركات الإسلامية، كان أجدر بها أن تقول:
إن هذه الفكرة الديمقراطية لا تلزمنا، ونحن أقدر على أن نستخرج من ديننا نظاما يجعلنا غير مرتبطين بفكرة التوقيت أو بفكرة الانتخابات ولكنه يجعلنا مرتبطين بتجنب الطغيان والاستئثار بالمنصب.. وذلك كي لا نضطر إلى عزل الأصلح عن منصبه وتولية من هو أضعف منه، وكي لا نُضطَرّ إلى انتظار مفاجآت الانتخابات التي لا تتوفر لها الظروف الطبيعية، حيث لا تتوفر الفرصة للقواعد لتقييم المهارات الإدارية والكفاءة في المترشحين للمناصب والولايات.
ألا تتفقون معي في أن بذل الجهد لاستخراج نظام كهذا، خير من الاستعلان بالإيمان بالديمقراطية والالتزام بالممارسة الانتخابية ثم يخرج الأمر في النهاية كنوع من المسرحية الهزلية المفضوحة؟!
السؤال هنا: هل تأتي الانتخابات دائما بمن هو أصلح وأكفأ؟
والجواب المؤكد الذي يتفق عليه الناس: لا، ليس شرطا.. قد تأتي بمن هو أصلح أو بمن هو أسوأ.
إذن، لماذا نحن مضطرون إلى اعتماد هذه الوسيلة دون غيرها؟
والجواب: لأننا لم نفكر في غيرها و/أو لا نعرف غيرها، أو لأننا نريد أن نثبت لعالمنا وحكوماتنا أننا ديمقراطيون، إحراجا لحكوماتنا و/أو إظهارا لنزاهتنا أمام الغرب.
***
أريد أن أقول بوضوح شديد، كي لا أترك أي مجال لتفسير كلامي تفسيرا خاطئا، أننا كأمة إسلامية أو كشعب مسلم أو كحركات إسلامية أو كفصائل ثورية أو .... أو .... أو ..... (أيا ما كان التوصيف).. أننا معنيون ومهتمّون ألا يتسلط علينا طاغية أو ظالم، لا بالقهر الصريح ولا بالانتخابات الشكلية.
ونحن معنيون ومهتمّون أن يسود علينا خيارُنا وأكفاؤنا سواء كان ذلك بانتخابات صحيحة أو بالموهبة والكفاءة التي أظهرتها الأيام والأحداث والتي فرضت نفسها.
ونحن معنيون ومهتمّون أن يبقى الأصلح فينا في موقعه ومكانه اللائق به، طالما كان قادرا على القيام بدوره، سواءٌ استمرّ في موقعه هذا سنة أو عشرة أو عشرين.. طالما أننا نملك دائما حق مراقبته ونصحه وتقويمه، ونملك حق عزله والخروج عليه إذا ظهر منه الفساد والانحراف.
وأنا أدافع عن موقفي هذا بعدد من الأسباب، هي كالآتي:
1. أن الديمقراطية والانتخابات فكرة أو وسيلة غربية ليست هي من ديننا، فنحن غير مُلْزَمين بها.. وإنما ننظر فيها كفكرة أو كأداة أو كوسيلة، فنأخذ بها طالما كان فيها خير للأمة، ولا نأخذ بها إن كان فيها شرٌّ للأمة.. ومسألة تأقيت عقد السلطة هذا من الأمور التي يجري فيها النظر وتقدير المصلحة والمفسدة.. فنحن غير ملزمين أن نعزل الأكفاء الأخيار لمجرد أنه قد حان وقتٌ ما يجب فيه أن ينعزلوا. ولا نحن كذلك ملزمين بالصبر على المفسدين والأشرار لمجرد أنه يلزمنا البقاء ساكتين لوقتٍ ما.
2. أن حالتنا الآن كمسلمين، وكحركات إسلامية، وكفصائل ثورية، و... و... و...، ليست هي حالة التمكن والاستقرار والراحة التي نجد فيها كثرة من الرجال القادرين على إدارة الصراعات، بل نحن في مراحل كفاح وتحرر وحروب استقلال ونزاعات مريرة مع احتلال أجنبي ومع طغيان داخلي.. ومثل هذه الأحوال لا يقوم لها إلا رجال نادرون، بما حباهم الله من المواهب والكفاءات. فليس من المعقول في هذا الحال أن نطعن أنفسنا بأيدينا، ونُلْزِم الأكفاء النادرين بمغادرة مواقعهم لمجرد أننا مخلصون للديمقراطية ومبادئها!!!
من في قادة الدول عند اللحظات الخطرة أو في زعماء الثورات وحركات التحرر أخلى موقعه خضوعا للديمقراطية؟!
3. أن الغرب الذي ابتدع الديمقراطية واخترعها وروّج لها وفلسفها وعلَّمنا إياها، هو نفسه لما رأى أن الديمقراطية تهدد مصالحه، دهسها ولم يبالي.. لم تطرف له عين ولم تهتز فيه شعرة.. وانظر إلى مذكرات أي صانع قرار أمريكي تجده يقول في بساطة ما مفاده الأخير: حين يكون الاختيار بين مصالحنا وقيمنا الأخلاقية نختار مصالحنا. لكن بعضهم أبرع من بعض في صياغة هذه العبارة بأشكال دبلوماسية وبلاغية ناعمة.
فلا يُعقل، والحال هكذا، أن نكون نحن أشد إيمانا بالديمقراطية من أهلها وأصحابها إذا كانت ضد مصالحنا.
4. أن الذين قُهِروا زمنا على الشكل الديمقراطي، بأثر من التفوق الغربي، يتحايلون عليها الآن، في الصين يُعَدَّل الدستور ليسمح للرئيس بِمُدَدٍ أخرى، وفي روسيا يدير بوتين لعبة طريفة مع أحد أتباعه (ميدفيدف) فيتبادلان موقع الرئيس ورئيس الحكومة، وفي عالمنا العربي مسرح حافل بكل مساخر الديمقراطية، استفتاءات شكلية واستفتاءات مزورة وانتخابات بين قوائم معينة واستفتاء على شخص وحيد واختيارات سابقة التجهيز وترتيبات لا تكفّ عن التجديد والإبداع غرضها واحد فقط: أن تأتي السلطة على الهوى الغربي.
فلماذا نحن من دون كل هؤلاء سنؤمن بالديمقراطية ونخضع لها مهما كانت أضرارها؟!
***
أعود فأكرر من جديد، وكمحاولة أخرى لئلا يُفهم كلامي على غير ما أقصد:
الديمقراطية والانتخابات ليست إلا وسيلة وفكرة، لسنا مجبرين على الأخذ بها ولا على الخضوع لها مهما كانت نتائجها.. ما يهمّنا الوصول إلى الغايات المقصودة من وراء الأفكار والوسائل:
ألا يتسلط علينا فاسد ولا مستبد، ألا نخسر صالحا كفئا في وقت الحاجة إليه.
February 3, 2021
أفاضوا في مدح النبي وماتوا كافرين!!
ليس كل من عرف محمدا صلى الله عليه وسلم أحبَّه، ولا كلَّ من عرفه آمن به واتبعه. فالقول بأن الشعوب الغربية لن يتغير موقفها كثيرا إذا عرفت نبينا –صلى الله عليه وسلم- ليس نوعا من التشاؤم أو هو ضرب من الوهم، بل هو أقرب لتقرير واقع، وتطبيق لفهم طبائع النفس والاجتماع.
وليس أقرب دليلا على هذا من أن قريشا لم يؤمنوا به ولم يتبعوه، وهم أعرف الناس به، فهم أهل النبي وعصبته، وفيهم وُلِد وكبر وعُرِف قدره وشرفه وخُلُقُه. بل تحول فجأة من "الصادق الأمين" إلى: ساحر وكاهن وشاعر ومجنون!!
فالجهل هو الحاجز الأول، ولكنه ليس الحاجز الأهم، والمعرفة وحدها لا تدفع صاحبها إلى اتباع الحق، وإلا فما كان يُتَصَوَّر أن يكفر إبليس وهو الذي عاش دهرا مع الملائكة، ورأى من الملكوت ما لم يره البشر. إن بين العلم وبين العلم حواجز من الشهوات والمصالح التي لا تهدمها إلا مجاهدة النفس وتحمل العواقب ودفع التكاليف، ولذلك "حُفَّت الجنة بالمكاره، وحُفَّت النار بالشهوات" كما في الحديث الصحيح.
وكنا في المقال السابق على صفحات هذه المجلة قد طرحنا سؤال "هل يتغير موقف الشعوب الغربية إذا عرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم"، وللإجابة على هذا السؤال افتتحنا موضوعيْن؛ الأول: هو ما يُسمى "علم نفس الطاعة" وهو من فروع علم النفس السياسي وعلم النفس الاجتماعي، حيث قد ثبت أن تأثير السلطة في الجماهير يبلغ من القوة بحيث أنها تفضل الطاعة والخضوع مهما كانت قناعتهم بخطأ القرار. وذلك ما تناولناه في المقال الماضي.
والثاني: هو سيادة المنهج الوضعي في التفكير والبحث العلمي في الغرب، وهو ما نشير إليه سريعا في هذه السطور، وبالله التوفيق.
كان من نتائج انقلاب الغرب على المسيحية، وإقصاء الدين من الحياة، أن دخل إلى الحياة العلمية ثم ساد فيها منهج الوضعية. حيث تمثل هذا المنهج في العديد من الفلسفات والأفكار والمذاهب، حتى صار أساسه راسخا وثمراته كثيرة وغزيرة.
الوضعية، بتبسيط شديد يناسب المقام هنا، هي المقابل والنقيض للمعيارية، ولكن ما هي المعيارية؟
المعيارية هي بمثابة الميزان والنموذج والمِثال الذي نسعى للوصول إليه. نريد مثلا أن نصل إلى نظام سياسي يحقق العدل ويقوم بالحق وينشر الفضائل، إن تصوّرنا للعدل والحق والفضائل هو المثال والنموذج والمعيار الذي نحاول الوصول إليه، وعلى ضوئه نستكشف القصور والأخطاء والنقص في واقعنا، فنسعى في تحسينه وتعديله، ونكافح في سبيل ذلك أولئك الظالمين والمجرمين الذين يتسببون في هذه الأوضاع الفاسدة ويغلقون طريق الإصلاح. وهكذا، كل دين أو فلسفة أو مذهب، له تصوّره عن العدل والخير والحق والجمال والأخلاق، ومن خلالها اختار شكل الإصلاح والكفاح، ومن خلالها بنى قوانينه وتشريعاته ونظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ما يهمنا هنا، أن العلم الصادر عن منظومة معيارية، يهتم بدراسة مجاليْن معا: يدرس "ما هو كائن" ويدرس أيضا "ما يجب أن يكون"، ويحاول أن يصل إلى أفضل السُبُل لإصلاح ما هو كائن كي ينسجم ويصل إلى ما يجب أن يكون. إنه علمٌ ذو ميزان ومعيار، فليس مقبولا أن تخرج نظريةٌ علميةٌ تدعو إلى مخالفة القيم والمبادئ والأخلاق الأساسية في هذا الدين أو هذه الفلسفة.
أما الوضعية، فهي التي تحاول أن تدرس ما هو كائن، ولا تهتم أصلا بمجال "ما يجب أن يكون"، لسبب بسيط: أنها قد أقصت وأزاحت وحاربت الدين، بما في ذلك سائر ما يتعلق به من أمور غيبية (ميتافيزيقية)، لقد قضتْ على وجود المعيار والميزان نفسه. وبهذا صار كل شيء مقبولا وممكنا وطبيعيا.
إذا انطلقت مجموعة من الرحالة والجغرافيين –مثلا- إلى رحلة مجهولة في مكان ما، واكتشفوا قوما من البشر لهم عادات وتقاليد وطقوس، سيهتم الرحالة "المعياري" أن يقيس أوضاع هؤلاء إلى المعيار والميزان الذي يعتنقه، فإذا رأى أنهم يأكلون لحم البشر فسيرسخ في نفسه أنهم قساة، وإذا رآهم يتزاوجون رجالا ونساء بغير عدد ولا تحفظ فسيرسخ في نفسه أنهم في إباحية وفوضى جنسية، إذا رآهم ينقسمون إلى طبقات تتفاوت في الحقوق والواجبات فسيرسخ في نفسه أنهم في ظلم... وهكذا! أما الرحالة "الوضعي" فلن يرى فيهم إلا قوما "مختلفين"! لهم عادات وتقاليد وأنظمة "مختلفة"! وما ذلك إلا لأنه ليس ثمة ميزان ولا معيار.
هذا المثال المبسط للغاية، وجد تطبيقات خطيرة له في سائر مناحي الحياة الغربية، ومن تلك المناحي: العلم. وأبرز مجالات العلم التي يبدو فيها هذا واضحا: الأخلاق. فلطالما كان علم الأخلاق علما يدرس ما يجب أن يكون، فتحول تحت ضغط الوضعية المادية إلى علم يدرس ما هو كائن، فالأخلاق في المنهج الوضعي ليست إلا "عادات قوم ما في زمان ما ومكان ما"، ليس أكثر من هذا.
ومن بين تطبيقات كثيرة وخطيرة لهذا الاتجاه، يهمنا في مقالنا هذا التركيز على ما وقع في الانفصال بين العلم والعمل.
لقد صار مألوفا تماما في الحياة الغربية أن تجد الباحث ينفق عمره في دراسة موضوع ما، ويصل إلى عدد من النتائج المهمة والممتازة، ولكنه لا يرى نفسه مكلفا باتباع النتائج التي وصل إليها، ولا اعتناق الأفكار التي أثبت هو صحَّتها، ولا الكفاح في سبيل ما برهن هو على أنه حق!! وكذلك زملاؤه في البيئة العلمية، لا يستنكرون عليه أنه لم يفعل!
لقد توقف عمل العالِم الباحث عند الفحص والدراسة وجمع الأدلة والبرهنة عليها وتقديم التفسير العلمي وتكوين صورة الموضوع المحكمة. عند هذه النقطة يرى هو –كما يرى زملاؤه- أن المهمة قد اكتملت. أما موقفه هو مما توصل إليه ومدى تطبيقه هو لقناعاته هذه في حياته، فأمرٌ آخر يُعَدّ من قبيل الحرية الشخصية التي لا يُسأل عنها!
لقد فاضت كتب كثير من المستشرقين بالثناء على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنجازه المُعْجِز في تحويل العرب من أمة مطمورة مغمورة متنازعة لا يتوقف القتال فيها إلى بناة حضارة وإمبراطورية عظيمة في زمن خاطف ولمحة بارقة، وفاضت كتب كثير منهم بالثناء على الإسلام وقيمه وحضارته وما قدَّمته الحضارة الإسلامية للعالم من بدائع الأفكار والقيم والتشريعات والقوانين وروائع العلوم والعمارة والفنون. ومع ذلك فإن أكثر هؤلاء لم يدخل الإسلام!
بل إن كثيرا من جوانب عظمة الإسلام لا يلتقطها إلا هؤلاء، لنشأتهم في حضارة أخرى وقدرتهم على المقارنة بين الإسلام وبين ما هم فيه، فإذا الذي تعوّدنا عليه لا يثير اهتمامنا ولا نعرف قيمته، بينما يبدو هذا عندهم شيئا بارزا ومتألقا ومثير للإعجاب. ومع ذلك فأكثر هؤلاء لم يدخل الإسلام!
انتشر في العالم الإسلامي مستشرقون لا يُحصى عددهم، وبعضهم لديه من العلم بالإسلام ومذاهبه وعلمائه ما ليس عند أكثر المسلمين، ولكنه لم يسلم. بعضهم قدَّم رؤى وتصورات عن المسلمين وعن الحركات الإسلامية في غاية الدقة والقوة، وأكثرهم لم يُسْلِم.
إن هذا الأمر المقبول تماما في الواقع الغربي هو نفسه من أقبح القبيح في ديننا، إذ يشدد الإسلام على ضرورة اتباع الحق مهما كانت التكاليف، وعلى التضحية في سبيله مهما ارتفع الثمن، والذين يعرفون الحق ولا يتبعونه هم "المغضوب عليهم" وهو أشر الناس، وإذا قال المرء ما لا يفعل فقد أصابه المقت العظيم (كَبُر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون). ولا يمكن لمن أمسك بكتاب في فضل العلم أو آدابه من تراثنا الإسلامي إلا وجد فيه كلاما عن ضرورة العمل، حتى لقد ألَّف الخطيب البغدادي –المحدث والمؤرخ المشهور- كتابا شهيرا جعل عنوانه "اقتضاء العلم العمل"، حشده بالنقول من القرآن والسنة وكلام السلف الصالح عن ضرورة العمل، وأن العلم إنما يُطلب للعمل.
ولقد نفر علماؤنا من مناقشة العلم الذي لا يترتب عليه عمل، وأنكروا على من يسأل الأسئلة التي لم تقع ولم تحدث، إذ العلم عندهم ليس رياضة نظرية لتمرين العقول وتنشيط الأذهان، بل هو هداية ونور لإصلاح العقول والقلوب والأبدان. وقد نُقل عن الكثير من العلماء النهي عن العلم الذي لا يُستفاد منه، والاستغراق في الدقائق والمُلَح والنوادر والغرائب التي لا يُنتفع بها.
هذا المنهج القبيح المستنكر في ديننا وتراثنا صار هو الأمر الطبيعي في الحضارة الغربية، ولست أحصي عدد المرات التي كنت أقرأ فيها لبعض المستشرقين في بداية تعرفي على كتبهم، فكنتُ أتوقع الواحد منهم سيعلن إسلامه في السطر القادم، من روعة ما يكتبه وقوته، ثم ينتهي الكتاب، ثم ينتهي أجله هو وقد مات كما كان، كأنما لم يعرف الإسلام!
لهذا نقول: إن الشعوب الغربية تحتاج أكثر من "معرفة" نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن المعرفة وحدها لن تنقل أكثرهم إلى الإيمان، بل ولن تثني أكثرهم عن الإساءة له صلى الله عليه وسلم. الشعوب الغربية –والشرقية وسائر الشعوب- تحتاج أن ترى المسلمين أقوياء أعزاء، حينها تتغير نظرتهم على الحقيقة. فإن تعذَّر اجتماع القوة والعزة فالعزة وحدها قادرة أن تجتذب منهم، فإن العزيز مهما ضعف ومهما افتقر يصير موضع إعجاب وتقدير، وأقل أحواله أن يصير موضع تساؤل واهتمام!
آخر ما تحتاجه الشعوب الغربية أن نخاطبهم بديننا خطاب المستضعف الذليل الذي يتوسل لهم أن يستمعوا وأن يتعرفوا على ديننا ونبينا، إن المبذول مملول، ولذلك قال ابن تيمية في بيان حكمة قتل سابّ الرسول: "الكلمة الواحدة من سب النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتمل بإسلام ألوف من الكفار ولأن يظهر دين الله ظهورا يمنع أحدا أن ينطق فيه بطعن أحب إلى الله ورسوله من أن يدخل فيه أقوام وهو منتهك مستهان".
نشر في مجلة المجتمع الكويتية، فبراير 2021
ابن تيمية، الصارم المسلول على شاتم الرسول، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، (الرياض: الحرس الوطني السعودي، د. ت)، ص505.
January 31, 2021
البلاء الشديد والميلاد الجديد: أربعة عشر عاما في جوانتانامو

قد اجتمع في هذا الكتاب ما تفرق في غيره.. ودعني أقرب لك الصورة..
يحتفي الناس بكتاب ابن تيمية "درء التعارض بين العقل والنقل" لأنه سدَّ ثغرة فارغة، بين منهج السلف والالتزام بالنص وبين طريقة الفلاسفة وتسليط المنهج الفلسفي على النص، فهو -أي الكتاب- ردٌّ أثري على الطرح الفلسفي، حيث ثَوَّر ابن تيمية نصوص القرآن ليهدم بها بناء الفلسفة الذي بدا برّاقًا وخدَّاعًا حتى استلب عددا من فضلاء المسلمين فصاروا ينصرون الدين بمنطق الفلسفة ومنهجها.
ويحتفي الناس بكتاب ابن القيم "مدارج السالكين" لأنه سدَّ ثغرة فارغة بين الروحانية الصوفية التي تنزع إلى الشطحات وتتفلت من الأحكام وتتذرع لنفسها بالنصوص الضعيفة، وبين الجفاف الفقهي والصرامة الحديثية التي تصنع عقلا عظيما لكنه أشبه بالمحامي والخبير القانوني الذي يفتقد إلى روحانية العابدين.. فجاء هذا الكتاب ليكون هو الأمنية، كما يقول رشيد رضا!
ويحتفي الناس بكتاب سيد قطب "في ظلال القرآن"، وذلك أنه التفسير الذي قصد إلى بيان هداية القرآن والتعمق في معانيه وتوجيهاته وإرشاداته، وقد جاء بعد زمن طويل من تفاسير عديدة تهتم في القرآن بالنحو واللغة والبلاغة والأحكام الفقهية والجدل العقدي.. وكل هذا مهمٌّ في بيئة لا يتهدد فيها الإسلام نفسُه، أما وقد تهدد الإسلام بين أبنائه فما كان أشد حاجتهم إلى تفسير يُجَلِّي لهم معاني القرآن وهدايته وتفوقه وسموه على مناهج الأرض. وهو الأمر الذي رامه قبل ذلك محمد عبده ثم رشيد رضا ولكن لم يُقَدَّر لهما أن يكملاه، فبلغ الأمر تمامه على يد الشهيد سيد قطب رحمه الله.
وهذا الكتاب "البلاء الشديد والميلاد الجديد" يستحق أن يوضع في ذات المكانة بين كتب المذكرات وأدب السجون.. فقد اجتمع فيه ما تفرق في غيره!
1. اجتمع فيه أن كاتبه داعية إسلامي، يحسن التعبير عن الإسلام والدفاع عن قضيته وبيان محاسنه.. ولو أنك نظرتَ إلى كتب أدب السجون في عالمنا العربي لوجدتَ عجبا، إن الأغلبية الساحقة من نزلاء السجون هم من الدعاة والإسلاميين، ولكن أقل القليل منهم هو الذي كتب تجربته في السجن!
فلو أنك نظرت إلى كتب أدب السجون لانطبع في ذهنك أن أغلب الذين ذاقوا السجن كانوا من اليساريين والشيوعيين والمتهمين في انقلابات عسكرية فاشلة.
لقد كان الإسلاميون أكثر المسجونين، وأقلَّ الرواة لتجربتهم.. بعض هذا لزهدهم في الكتابة والرواية وبعضه لأن الظرف الأمني والسياسي لم يكن ليسمح بهذا.
2. وحتى الذين كتبوا تجربتهم من أولئك الإسلاميين، قد ندر فيهم من كتبها بقلمٍ بليغ وأسلوب بديع.. لقد جاء أغلب هذا كتابة خبرية تقريرية توثيقية.. بعض هذا لقلة الاهتمام بالأسلوب، وبعضه لأن الظرف الأمني والسياسي كان يناهض روايتهم فكانوا يكتبونها كإثبات وتوثيق أكثر من كتابتها لغرض الإفادة والتوجيه.
لقد اجتمع في هذا الكتاب عقل الداعية المسلم الذكي، مع القلم الأديب البليغ حسن البيان.. لقد كان المؤلف ذا علم غزير وذا بيان جميل، ولا يُزاحم كثرة المعاني الذكية الفائقة في كتابه إلا كثرة التشبيهات البديعة والعبارات الرائقة.
3. لم يكن جوانتانامو سجنا وحشيا كما هو حال السجون في الصين وروسيا والعراق وسوريا ومصر والأردن والمغرب.. لم تكن محنته في التقطيع والتعليق والسلخ وهتك الأعراض.. كان توحش هذا السجن توحشا على الطريقة الحديثة، على طريقة الحضارة الغربية.. إنه السجن الذي لا يسمح لك بالموت شهيدا في سبيل الله، بل يحاول أن يسلب إيمانك من قلبك، ويسيطر على مراكز التفكير في عقلك، ونقاط المشاعر في نفسك!
سجن أنشأه علماء نفس، لا لكسر العدو، بل "لترويضه".. سجنٌ يريد منك أن تتوب إلى الغرب وتقف باكيا على أعتابه، مؤمنا بأنك قد أخطأت في حقه، معترفا وموقنا في قرارة نفسك بأنك ارتكبت إثما عظيما حين فكرت في مقاومته، بل حين فكرت في إغاثة من سحقهم هو بيده!
لذلك اجتمع في جوانتانامو من قاومهم، ومن ذهب إلى الإغاثة، ومن ظل على الحدود يغيث من بعيد..
ولئن كان الأسير في السجون الوحشية على الطريقة الشرقية والعربية لا يجد له ملجأ إلا الإيمان، رغبا أو رهبا، حبا أو اضطرارا، فإن سجين الحضارة الغربية يوضع إيمانه على المحكّ!!
ولقد نجحوا أحيانا.. في هذا الكتاب ترى مسلمين قد ارتدوا، ومزقوا المصاحف بأيديهم، وترى من كان مجا هد ا في الصفوف الأولى يوما قد عمل جاسوسا على إخوانه، وترى من كان يصوم النهار ويقوم الليل وقد تطوع ليوقع غيره في المشكلات إرضاء للأمريكان!!
هنا ترى زلزلة النفس، وانقلابها، وتقلبها بين السمو والدُنُوّ، بين السموق والسفول..
نجحوا أحيانا، وفشلوا كثيرا.. تاجر المخدرات الذي سيق إلى جوانتانامو بالخطأ فأشرقت روحه فانقلب حاله، وآخر فضَّل البقاء في جوانتانامو على أن يُفرج عنه ليذهب إلى أوروبا خشية الفتنة، يوسف جديد يقول (رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه)، وآخر قد بلغ الغاية من النحافة والنحول والهزال ولكن همَّته أعجزتهم فكان يبلغ منهم وهو في أسره وضعفه ما جعلهم يندفعون إلى قتله والتخلص منه! وآخر قد خرج من جوانتانامو فصار مفاوضا للأمريكان ضمن وفد طالبان! وآخر قد خرج منه فعاد لمواجتهم مرة أخرى حتى قضى نحبه!!!
بل انقلب عليهم الأمر أحيانا أخرى، لقد أسلم عدد من الجنود الأمريكان بعدما رأى الإسلام يشع من هؤلاء الأسرى! ووقف المحققون معجبون أو متحيرون من صلابة هؤلاء واجتماعهم على غير أرحام ولا أنساب!!
4. ألم أقل لك قد اجتمع في هذا الكتاب ما تفرق في غيره؟!.. إذا كنت قد قرأت شيئا عن مآسي السجون المصرية أو السورية أو المغربية ... فهنا في جوانتانامو جاءك المصري والمغربي واليمني والسعودي والأفغاني والتركستاني والموريتاني.. أمة واحدة في سجن واحد!!
انتظر انتظر.. قد جاءك أيضا آخرون، قد جاءتك وفودٌ أمنية من البلاد العربية لتحقق مع المعتقلين.. سترى في هذا الكتاب قصة الوفد الأمني المصري، وقصة وفد أمني كويتي، وقصة وفد صيني، وقصة وفود أخرى لم يشأ المؤلف أن يُعَيِّنَها..
قد اجتمع في جوانتانامو خلاصة الظلم، وخلاصة المظلومين، قد نطق جوانتانامو عن نفسه بأنه ساحة المعركة الحضارية العالمية، حين يأتي مصري ومصري، بعضهم أسير وبعضهم يحقق معه، على الأرض الكوبية التي احتلها الأمريكان.. هل كان بوسع أحد أن يُلَخِّص حقيقة ما يحدث في هذا العالم أبلغ وأخصر وأوجز من أن يضع لك هذه الصورة؟!
5. كنتُ في منشور سابق، سأضع لك رابطه في نهاية هذا المقال، قد ذكرتُ أن من فوائد القراءة في أدب السجون أن تتعلم منها طبائع النفس والجماعات بأسلوب بسيط ومفهوم ومَحْكِيّ بدلا من كتب علوم النفس والاجتماع التي تمزق طبيعة المأساة الإنسانية لتحقق انسجامها التصنيفي الدراسي الصفيق الغليظ..
في هذا الكتاب أبدع المؤلف في وصف مشاعر النفس وتأملاتها ومآزقها ومحنها.. إنها أربعة عشر عاما في جوانتانامو.. حيث اليوم الواحد مزدحم بالمآسي فكيف بالأعوام الطويلة!
كذلك أبدع في وصف مجتمع المقهورين، وما ينشأ بينهم من الروابط، ثم ما ينشأ بينهم وبين سجانيهم وجلاديهم من العلاقات، وكذلك مجتمع الجلادين والسجانين.. دفقة قوية في علم الاجتماع تأخذها عمليا من حكاية جوانتانامو.
ولأن المؤلف -حفظه الله- على قدر عال من العلم والفقه في الدين فقد كانت تأملاته ومواقفه مربوطة دائما بالقرآن والسنة وقصص الأنبياء والصالحين.. وبهذا اجتمعت المعاني التربوية العميقة بالتأملات النفسية واليوميات الجماعية.. لم أر أحدا من قبل استطاع أن يبلغ هذا المستوى!
ولأن المؤلف قصد إلى بيان الحقيقة، فإن الواقع يظهر في هذا الكتاب كما هو، يظهر معقدا ومربكا ومستعصيا على القوانين والمعادلات البسيطة.. فليس كل مظلوم بطلا ولا كل ظالم فاجرا، ولا كل من عرف الحق اتبعه، ولا كل من جهل الحق أنكره، ولا كل الذين خاضوا اختبارا عسيرا فجازوه بنجاح استطاعوا أن يجتازوا بقية الاختبارات!!
6. بقي أن ترى في هذا الكتاب طبيعة العدالة الأمريكية، وطبيعة الحضارة الغربية، وطبيعة الحكومات العربية والإسلامية.
ستراها في غرائب المعتقل وعجائبه، حين يأتي محقق ويقول للأسير: لقد اكتشفنا -بعد عشر سنوات- أنك برئ فعلا وأنك ذهبت إلى الإغاثة، ولكن هذا لن يغير من حالك شيئا!
حين يُسَلِّم العملاء تاجر مخدرات باعتباره مسؤولا ماليا خطيرا لطا لبا ن، رغبة في الجائزة الأمريكية، فيكتشف الأمريكان هذا، ولكنهم لا يفكرون في الإفراج عنه بل يفكرون في تشغيله كجاسوس على بقية الأسرى.
حين يأتي جون ماكين إلى المعتقل، ويبدي تعاطفه معهم، ثم يذهب إلى الكونجرس ليعارض إغلاقه!
القصص كثيرة.. امتدَّ بها الكتاب حتى جاوز خمسمائة صفحة ضيقة السطور!!
7. لو كان لي من الأمر شيء، لفرضتُ تدريس هذا الكتاب على سائر المحاضن التربوية وسائر المجموعات الدراسية.. فقد اجتمع فيه ما يُغني عن الكثير جدا جدا من غيره!
إنه كتاب عظيم حقا.. أسأل الله أن يحفظ مؤلفه وأن يحفظ عليه دينه وأن ينفع به وأن يختم له بالحسني.
وأسأله تعالى أن يجيرنا وإياكم من الضعف والذل، ومن القهر والأسر، وأن يبلغنا أيام العزة والنصر!
اقرأ: كلمة في أدب السجون:https://www.facebook.com/mohammad.elh...
January 3, 2021
هل يتغير موقف الشعوب الغربية إذا عرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم؟
انقلب الجندي بعدها إلى وحش، صار نارا على الأسرى، أو بتعبير فايز الكندري "رضي أن يكون آلة في هذه المنظومة الظالمة التي لا تراعي أبسط الحقوق الإنسانية، فألغى عقله في معرفة الحق والباطل والظلم والعدل، وألغى قلبه الذي يطالبه بأن يكون إنسانا يُعامل الآخرين بإنسانية"[1].
أتّخذُ هذه القصة مدخلا للإجابة على بعض استدراكات القراء التي وصلتني على المقال الماضي ( https://bit.ly/2X9apgK )، إذ قُلْتُ بأن الشعوب الغربية ضحية للخطاب الإعلامي الكاذب عن المسلمين والذي تنتجه شبكات السلطة والنفوذ الغربية –كما عرضنا ذلك من خلال تجربة المستشرق الفرنسي المعاصر فرنسوا بورجا[2]- إلا أنه حتى إذا أتيح لبعضهم معرفة الحق فلن تكون مجرد المعرفة كافية لانتقاله من معسكر الغالبين إلى معسكر المغلوبين مُضَحِّيًا في ذلك بامتيازاته وترفه ومتحملا تكاليف معاكسة التيار.
ولهذا فإن حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية هي أقل ما يفعله المسلمون لاستعادة كرامتهم، إذ تلك هي الوسيلة التي يمكن أن تكون مؤلمة ومفيدة في تنبيه هؤلاء إلى خطورة النيل من نبينا صلى الله عليه وسلم، وبها يضع المسلمون أنفسهم ضمن شبكة القوى وشبكة المصالح التي تؤثر على اختيارات هذه الشعوب.
لكن يبرز السؤال هنا: لماذا تكون معرفة الحق غير كافية وحدها لاتباعه عند أغلب الناس؟ ولماذا يرضى أغلب الناس بمخالفة الحق –بل ومحاربته- في سبيل منفعتهم الذاتية؟!
ذلك واحدٌ من الأسئلة التي كم هلكت فيها العقول وفاضت الكتب في محاولة الإجابة عنها، ولن يمكن أن نقدم الإجابة ولا أن نختصر ما قيل في هذا المقال، وإنما نهدف من هذه السطور القادمة إلى بيان أن الشعوب الغربية تهيمن عليها مناهج فكرية ونظم سياسية وُلِدت في مسارات تاريخية بعينها، تجعل من المستبعد أن يتغير موقف هذه الشعوب مهما اجتهدنا في إيصال الصورة الصحيحة لديننا ونبينا إليهم.
علم نفس الطاعة
من بين الفروع التي يدرسها علم النفس السياسي، فرع عن علم نفس الطاعة، وتبرز في هذا الفرع تجارب ستانلي مليجرام الشهيرة التي توصلت إلى أن 65% ينفذون ما يُطلب منهم فعله مهما كان هذا الطلب يؤذي الآخرين أو حتى يقتلهم.
تتضاعف نسبة الطاعة في حالات أخرى، من أهمها حين يكون الذي يُصدر الأمر جهة فوقية، فالاعتقاد في أن الذي يطلب أو يأمر أوسع علما أو أكثر مالا أو أرفع شأنا يجعل الطاعة تزداد، وأما إذا كان الآمر يمثل السلطة التي تملك الجزاء والعقاب، فنسبة الطاعة تزداد إلى حدودها القصوى، ولا يبقى إلا النادر الذي يفكر في التمرد أو يقوى على تنفيذه. وأسفرت التجارب أن الإنسان وهو يقوم بهذا العمل غير الإنساني يُنْتِج مبرراته لنفسه، وهذه النقطة الخطيرة أشار إليها رئيس سابق لجهاز الاستخبارات الأمريكية –كما أورد ذلك ستيفن جراي في كتاب "أسياد الجاسوسية الجدد"- في درسه للمتدربين على قيادة شبكات التجسس، فقد أخبرهم أنه ليس من المُجْدي كثيرا بحث المداخل والدوافع لتجنيد العميل، بل يجب إيقاعه في الخيانة فعلا، ثم سيتولى هو بنفسه إيجاد المبرر لنفسه[3].
كذلك تتضاعف نسبة الطاعة حين تكون المسافة بعيدة، فالذي يمارس القصف بالطائرة أو بالصاروخ لا يشاهد نتيجة عمله على الضحية، ومن ثَمَّ فلا يفكر في الرفض أو التمرد، بينما تزيد احتمالية التمرد لو أنه سيقتل بالسكِّين. وتكمن الفائدة العملية من هذه النتيجة في أن تقسيم الجريمة إلى مجموعة من الأعمال تجعلها أسهل عليهم جميعا، فالذي يأمر بقصف المدنيين –مثلا- لن يتألم لأنه لا يفعل أكثر من كتابة قرار، والذي يوصل القرار إلى الهيئة التنفيذية لن يشعر بأي ألم جراء مشاركته في هذه المذبحة، ومثله الذي يرتب خطة القصف، وكذلك الذي يشحن الطائرة بالصواريخ، وكذلك الطيار الذي يلقي القنبلة، وبطبيعة الحال لن يشعر بالألم كل الفريق العلمي والصناعي الذي أنتج القنبلة.
وتتضاعف نسبة الطاعة أيضا حين تكون الضحية قد جرى تشويهها أو نزع الإنسانية عنها، مثلما يحدث في السجون –مثلا- من إلغاء اسم السجين واستبدال رقمٍ به، أو الحديث المتكرر عن غبائه أو عن خبثه وخطورته.. إلخ! إن هذا يجعل عملية الإيذاء مبررة بل وضرورية، إن لم تكن شيئا مطلوبا ومرغوبا فيه لتخليص البشرية أو الوطن من عنصر الشرّ هذا أو على الأقل: لتجنب خطورته وخبثه!
إذا جمعنا بين هذه الأمور الثلاثة: تأثير الجهة الفوقية والسلطة، وتأثير تقسيم العمل إلى أجزاء صغيرة، والتشويه المتكرر للعدو، وطبقناها على حالتنا هذه، فسنجد أنه من الصعوبة جدا أن يتغير موقف الشعوب الغربية من النبي ومن المسلمين:
فنحن إزاء شبكة سلطوية قوية مُنْتِجة لصورة المسلمين في الغرب، تتمثل في نخبة متميزة من السياسيين والوزراء والمثقفين والأكاديميين والصحافيين وحتى الممثلين، والكلمة من هؤلاء تجد طريقها بغير صعوبة إلى عقول عموم الناس هناك وقلوبهم، فليس من طبائع البشر أن يناقضوا قولا يتفق عليه ويردده زعماؤهم وأعيانهم وكبارُهم.
ثم إنه ليس مطلوبا من عموم الناس هناك ارتكاب جرائم مباشرة ضد المسلمين، بل على العكس، ليس مطلوبا إلا الإبلاغ عمن يعتقدون أنه يمثل خطورة وتطرفا، مع تقديم الدعم الاجتماعي لإجراءات الحكومة، وهو ما يكفي فيه مجرد السكوت والوقوف في مكان المتفرج الذي لن يرتكب شيئا بيده. وأما الأجهزة الحكومية التي ستنفذ قرارات السلطة فإن العمل مقسَّم فيما بينها بحيث لن يشعر أحدٌّ ما بنوع من ألم الضمير، لأنه مجرد منفذ لجزء صغير من سياسات كبرى هو لا يستوعبها ولا يعرف نتائجها على الضحية.
وحتى إذا شعر البعض بتأنيب الضمير، فإن الميراث الطويل من خطاب الكراهية الذي يتحدث عن الخطر الإسلامي قد صنع فعلا حالة من الخوف المرضي من الإسلام (الإسلاموفوبيا)، وهذا الأمر يعمل كمُخَدِّرٍ ومُنَوِّمٍ للمشاعر المتعاطفة مع الضحايا، كما يعمل كحافز ومثير للمشاعر المتضامنة مع الدولة والسلطة والأجهزة التي تنفذ واجبها في حماية المجتمع من الأخطار المحتملة!
وإذا افترضنا أن مواطنا صالحا في فرنسا أو في غيرها من بلاد أوروبا كان يكتفي بموقع المتفرج، أو حتى تسيطر عليه عاطفة التضامن مع الضحايا، فإن هذا المواطن بمجرد أن يتولى وظيفة في الشرطة أو الجيش أو نحوها من الأجهزة التي تتولى هذه الحرب ضد المسلمين، الأغلب أن هذا المواطن يتحول تحولا مفاجئا إلى جندي مخلص في هذه الحرب، على ذات النحو الذي فعله الجندي الأمريكي الذي ذكرناه في بداية المقال. فتلك هي نتيجة التجارب النفسية العديدة التي أجراها العديد من خبراء علم النفس الاجتماعي، وتناولها كثيرون مثل سولومون آش وستانلي مليجرام وفيليب زمباردو وديفيد باتريك هوتون وباتريك بوكانان وحنة أرندت وزيجمونت باومان وغيرهم[4].
إن نسبة نادرة يمكنها أن تقاوم الحالة الاجتماعية السائدة، لا سيما في مجتمعات تهيمن عليها العلمانية والإلحاد، وتضمر فيها الهيمنة الأخلاقية، بحيث يمكن لأي عمل مهما كان وضيعا أن يوجد له المبرر الذي يجعله ضرورة أو حتى يجعله مرغوبا فيه.
وأندر منها نسبة الذين يقاومون السلطة أو يتمردون عليها، وهذا أمرٌ نلمحه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم "ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن لهم عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا"[5]. فمما نتبنه من هذا الحديث أن مقاومة عنصر الجهاز الأمني أو العسكري أو المالي لأوامر السلطة الظالمة أمرٌ لا يكاد يُستطاع، فجاء النهي النبوي عن الدخول فيه من الأصل.
كان هذا كله عاملا واحدا، وهو "علم نفس الطاعة" الذي يحمل الشعوب على أن تظل في مواقعها العدائية حتى وإن وصلت إليهم الصورة الصحيحة عن النبي وعن المسلمين، مع أن هذا افتراضٌ جدلي على سبيل التنزل، إذ كيف يمكن منافسة الشبكة السلطوية المهيمنة على شعب ما فضلا عن التغلب عليها لإعادة تشكيل وعي الشعب.
وبقي أمر آخر نؤجله إلى المقال القادم إن شاء الله، وهو أمر المنهج الوضعي الذي ساد في أوروبا منذ عصر التنوير، وكيف ساهم هذا المنهج في الانفصال بين العلم والعمل، وبين العلم والأخلاق، بمعنى: أنه صار طبيعيا ومتكررا أن يتوصل عالِمٌ ما أو مستشرق ما إلى الإعجاب القوي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالحضارة الإسلامية ثم لا يشعر أنه مُلزم باعتناق الإسلام واتباع هذا النبي. كيف نشأ هذا المنهج في التفكير وكيف ساد؟.. هذا ما يكون في المقال القادم إن شاء الله وقدَّر.
نشر في مجلة المجتمع الكويتية، يناير 2021
-----------
[1] فايز الكندري، البلاء الشديد والميلاد الجديد، ط1 (بيروت: جسور للنشر والترجمة، 2020م)، ص109، 110.[2] محمد إلهامي، "كيف تتشكل صورة المسلمين في الغرب: خبرة مستشرق فرنسي"، مجلة المجتمع الكويتية، ديسمبر 2020م.[3] ستيفن جراي، أسياد الجاسوسية الجدد، ترجمة: مركز التعريب والبرمجة، ط1 (بيروت: الدار العربية للعلوم، 2016م)، ص218.[4] للمزيد، انظر "الإذعان للسلطة" (Obedience to Authority) لستانلي مليجرام، وعلى حد علمي فإن هذا الكتاب لم يترجم للعربية، ولكن تجربته ونتائجها تناولها العديد من الكتب والدراسات الأخرى، و"تأثير الشيطان" لفيليب زمباردو، و"علم النفس السياسي" لديفيد باتريك هوتون، و"الذرة الاجتماعية" لباتريك بوكانان، و"آيخمان في القدس" و"تفاهة الشر" كلاهما لحنة أرندت، و"الحداثة والهولوكوست" لزيجمونت باومان.[5] رواه ابن حبان (4586) وغيره، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (360).
December 26, 2020
كلمة عن كتاب "حياتي في رحاب الأزهر"
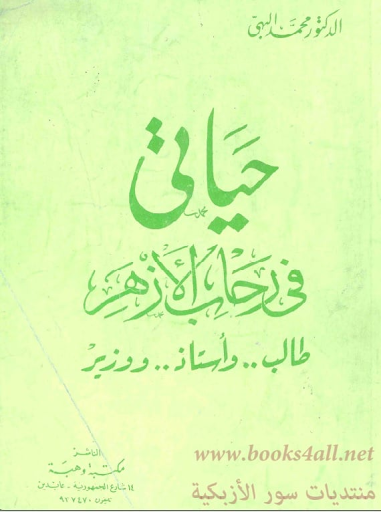
لكم وددتُ أن تطول هذه المذكرات، وتكون أكثر تفصيلا، وما ذلك إلا لأحاول فهم شخصية صاحبها، فإنه أحد الشخصيات المُحَيِّرة.إنه محمد البهي..المفكر الإسلامي الكبير الذي فاضت ألسنة الكثيرين من مشايخنا في مدحه والثناء عليه، وأولئك الذين مدحوه أبعد من أن يُتَّهموا بنفاق، فمنهم القرضاوي وأحمد العسال وعبد الجليل شلبي وأنور الجندي ومحمد عبد الله السمان وغيرهم.وهو مع ذلك الوزير في عصر عبد الناصر، في أشد حقبة عبد الناصر ظلاما، إذ كان وزيرا لشئون الأزهر، وكان واحدا من رجال قانون "تطوير الأزهر"، أو بالأحرى تحطيم الأزهر، وهو الذي نَفَّذ بنفسه تحجيما لشيخ الأزهر لم يجرؤ عليه أحد من قبله، حتى لم يجد شيخ الأزهر (محمود شلتوت) حينها إلا أن يرفع شكايته لمجلس الدولة يحاول أن يسترد شيئا من كرامته، فإذا بمجلس الدولة ينصر الوزير عليه (وهذا هو المتوقع في ظل قانون وُضِع أصلا لتحطيم شيخ الأزهر)، فلم يجد شلتوت إلا أن يعتكف في بيته مريضا حتى مات!ثم هو مع ذلك الرجل الذي لما سأله عبد الحكيم عامر عن رأيه في كتاب سيد قطب "معالم في الطريق" قال: تمنيت لو أنني كتبتُ هذا الكتاب، فإن فيه رأي القرآن.. متعرضا في ذلك لدهشة عبد الحكيم عامر -الرجل الثاني، ربما الأول في ذلك الوقت- وغضبته!محمد البهي..الرجل الذي فاض لسانه وقلمه في التحذير من المستشرقين، وهضم الفكر الغربي، حتى إن سيد قطب حين أراد تلخيص هذا الفكر لم يجد خيرا من أن ينقل من كتاب البهي "الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار".. وهو كتاب فاخر جميل يوصى به. ومع ذلك لا تجد مستشرقا يناقش انحدار شأن الأزهر إلا وهو جذل أو مستغرب من دور البهي في إمضاء قانون الأزهر المشؤوم عام 1961.الرجل الذي لا يُشَكُّ في صدق همّه وهمته لاستئناف الحياة الإسلامية، وإعادة المكانة للشريعة الإسلامية، ولكنه كان حريصا على تطبيق القانون الوضعي تطبيقا صارما كأنما هو الشريعة، أثناء حياته كأستاذ وكرئيس للجامعة وكوزير!الرجل الذي كانت له من الجرأة أن يحاضر ويكتب ضد الشيوعيين في ذروة قوتهم بمصر في مطلع الستينات من القرن العشرين، ثم لا يقترب منه أحد، إلا أن تُمْنَع كتبه من الطبع، أو تُصادر إذا طُبِعت خارج مصر. ومع ذلك فهو يحظى بحماية عبد الناصر نفسه في مقابلة عبد الحكيم عامر وزوجته برلنتي عبد الحميد!!الرجل الذي شُهِد له بالنزاهة ونظافة اليد والنفور من أية مكاسب، حتى أنه لم يستطع أن يشتري مسكنه.. كيف لهذا أن يكون وزيرا في عصر عبد الناصر الذي كان وزراؤه أمثلة نموذجية في الفساد والانحلال؟!لكم تمنيتُ أن تحل هذه المذكرات لغز هذه الشخصية، ولكن اختصارها وأخبار شذراتها لم تشفِ غليلي.لقد مرَّ بسرعة على قانون تطوير الأزهر، ولم يُشر إلى دوره في إقراره إلا بكلمات بسيطة.. ولا مَدَح القانون ولا أثنى عليه (مع أنه كان مستبشرا به كثيرا في خاتمة كتابه: الفكر الإسلامي الحديث).. ومرَّ على الأحداث الفاصلة في عصره دون أن يشير إليها. لقد انصب اهتمامه على توضيح مواقف شخصية ونزاعات بينه وبين أساتذة الجامعة أو مسؤولي الوزارة!لا أجد تفسيرا لهذه الشخصية إلا أن هذا الرجل المستقيم في نفسه، البعيد الهمة والكثير الهمّ، إنما كان مصابا بما أسميه "فيروس الدولة"!!.. وهو الفيروس الذي يصيب صاحبه بالشغف بالخضوع والنظام وتنفيذ القانون حرفيا مهما كان القانون جائرا، والسعي للإصلاح بقدر ما تتيحه السلطة من مساحة، وبحسب ما تتيحه السلطة من أدوات. فإن اعترض على شيء لم يكن له أن يكافح أو يناضل بل أن يكتم غيظه في نفسه، مستمرا في تأدية مهمته على الوجه الأمثل كما يفعل "المواطن الصالح"!ترى هل يكون غيظ هذا "المواطن الصالح" منبعثا من انتهاك الدولة للعدل والحق؟ أم من انتهاكها لقانونها الذي وضعته؟!.. في مثل حالة الشيخ محمد البهي: لا أستطيع الإجابة.لقد تفتحت حياة الرجل في ألمانيا، حيث كان في بعثه، وذلك في زمن هتلر، في السنوات التسع الذهبية التي عادت فيها ألمانيا كماكينة عمل هادرة، وتلملم شتاتها وأشلاءها من الحرب العالمية الأولى لتتحول فيما يشبه غمضة العين إلى قوة فظيعة تكاد تلتهم أوروبا كقطعة من الحلوى!تضرب ألمانيا، منذ بسمارك وحتى الآن، مثلا نموذجيا في الدولة القوية التي تهيمن على شعب نشيط، كأنما هي مصنع كبير مُحْكَم التصميم، وتقدّم نموذجًا يُدرَّس في العلوم السياسية عن السلطة التي تستطيع إنشاء شعب على وفق مثالٍ منضبط. ومن خلال مذكرات من عاشوا ذلك الزمن، نرى أن هذا النموذج قد بلغ ذروته في هذه السنوات التسع (1930 - 1939م).. وتلك هي السنوات التي عاشها صاحبنا هناك.هل يصلح هذا لتفسير ما يبدو كتناقضات لدى محمد البهي؟!هل يكون إيمانه بالإصلاح السلطوي، والتنفيذ الحرفي لتوجهات السلطة، هو الذي دفعه لما يُعاب عليه من العنف الشخصي والقسوة الإدارية والسعي نحو قانون تطوير الأزهر على هذا النحو؟لقد كان مؤمنا أن الأزهريين لن يُصلحوا من أنفسهم أبدا، وكان مؤمنا أن الحل كامن في إجبار الأزهريين على تعلم اللغات الأجنبية والعلوم الحديثة.وهو في قسوته الإدارية وعنفه في موقع المسؤولية يُذَكِّر بما قيل عن ابن خلدون، الذي كان إذا تولى القضاء بدا عنيفا شديدا، فإذا عُزِل عنه بدا سهلا رقيقا رفيقا.إلا أنه في هذا يخالف محمد عبده، فمحمد عبده رغم قربه من السلطة الإنجليزية التي كانت تحتل مصر، ورغم تشوقه الكامل لإصلاح حال الأزهر بما قد يقترب من رؤية محمد البهي (بالمناسبة: محمد البهي يرى نفسه من مدرسة عبده) إلا أنه حين كان يقع الاختيار بين "إصلاح" يفرضه الإنجليز فرضا على شيوخ الأزهر لم يكن يسعى في هذا بل كان يتوقف عنه، كان عبده في نهاية الأمر يريد أن يحتفظ للأزهر بهيبته ومكانته وألا يكون شأنه في متناول السلطة، لقد كان عبده مدركا أن الأزهر لم ينحط إلا حين سيطرت السلطة على أوقافه وشيوخه منذ محمد علي، وكان متحسرا على هذه الأزمة: فلا أهل الأزهر يرغبون في تطوير حاله، ولا إصلاحه سيكون على يد العدو المحتل، وقد روى رشيد رضا عنه في هذا الأمر ما يُصَوِّر حجم حسرته.فارق محمد البهي محمدًا عبده في هذا النهج، وكان ذراعا للسلطة في ضرب الأزهر.على كل حال، إن هذيْن القرنيْن، هما عصر الهزيمة.. وهو عصر تلتبس فيه الحلول على أهل العقول، عصر يصير فيه الحليم حيرانا، لا يدري ماذا يفعل.. والقاعدة عندي أن من ثبت ولاؤه للإسلام وهمّه في العمل له يوسع له في الإعذار ويُغَلَّب في شأنه حسن الظن، ولا يمنع هذا من الإنكار عليه والإشارة لما وقع فيه.ونسأل الله أن يهدينا إلى أرشد الأمور، وأن يخرجنا من هذا الضعف والوهن.
December 21, 2020
كلمة عن كتاب "الدولة المستحيلة"
منذ أن أنهيتُ كتاب "الدولة المستحيلة" لوائل حلاق، وأنا أهيئ نفسي لتدبيج مقال مطوّل عنه، ومع الأسف يمرُّ الوقت وتجتمع المشاغل مع ضعف الهمة فلا يلبث المرء إلا أن يكون بين خياريْن: إما أن يُدرك بعضَ ما نوى أو أن يتخلى عنه كله.
ولهذا، فما هذه السطور إلا خواطر متناثرة، لا تزال تترسب في الذاكرة، قدَّرْتُ أن بثَّها خيرٌ من طيِّها.
[1]
بداية، ولكي نريح القارئ العجول، فأنا في صفّ المعجبين بالكتاب والمؤيدين لفكرته، والفكرة البسيطة للكتاب أن نموذج النظام الإسلامي مختلف جذريا ومتناقض تماما مع نموذج الدولة الحديثة، ولا يمكن التوفيق بين هذين النموذجيين، إذ أحدهما ديني أخلاقي أنتج بالفعل نظاما عاش 1300 سنة، فضلا عن تجذره في نفوس المسلمين وعالمهم بما يجعل انخلاعهم عنه وانخلاعه عنهم مستحيلا، مثلما يستحيل انخلاع الأوروبي من إرثه اليوناني والمسيحي والتنويري.. بينما النموذج الثاني علماني مادي وهو ابن تجربته الغربية، التي جعلت الدولة إلها حقيقيا متغولا وسائدا على المجتمع، مع أنه ليس لها لا رحمة الإله ولا حكمته، كما أنه ليست لها أخلاق، بل هي نظام عنيف مدمّر ولا إنساني.
وبالتالي -يقول حلاق- فالمسلمون حين يتطلعون إلى "دولة حديثة" كالتي في العالم الغربي، فإنهم يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير! بل يجب على الغرب أن يحاول حل مشكلة الحداثة بالنظر إلى التراث الإسلامي وما فيه من هيمنة أخلاقية قوية.
2. هذه الفكرة في جوهرها ليست جديدة، بل طرحها آخرون من المستشرقين والمسلمين منذ مائة عام على الأقل، ولم تزل تتردد في أروقة البحث ذي الصلة بهذا الموضوع.. ولكن قيمة كتاب حلاق هذا في أمرين؛ الأول: أنه خدم هذه الفكرة وتعمق في إثباتها بنقولات غزيرة من حقول القانون والفلسفة والسياسة لأعلام الفكر الغربي، تدلّ على تمكنه من مادته، وقدته البارعة على المقارنة الموفقة بين النموذجين الإسلامي والغربي. والثاني: هو هذا العنوان التشويقي الإثاري في الزمن الملتبس.
[2]
سأفترض جدلا أن اختيار حلاق للعنوان كان بريئا، وهذا أمر مستبعد جدا، لكن الذي يهمنا الآن أكثر من التفتيش في نواياه أن العنوان غير معبِّر بدقة عن فكرته.. فالكتاب أصلا لم يؤلف ليقرأه المسلمون، بل غرض تأليفه وجمهوره هم الغربيون الذين يُحاول تبصيرهم بعيوب الحداثة وكيف أنه يمكن أن نجد لها حلا في التراث الإسلامي.. فالعنوان الفرعي أدق في التعبير عن غرض الكتاب "الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي"!
ولكني أعرف تماما أنه لو كان هذا هو عنوان الكتاب، فلم يكن أحد ليتشجع لترجمته، ولم يكن مركز عزمي بشارة ليتحمس لنشره، ولكن عزمي بشارة يحمل مشروعا فكريا من أركانه إقناع المسلمين باستحالة عودة الدولة الإسلامية، حتى لو اعترفنا -حقا أو تخديرا- بأنها كانت دولة عظيمة في زمانها وضمن ظرفها التاريخي!
لقد كان عنوان الكتاب واقعا بقوة ضمن مشروع عزمي بشارة.. ولعله لهذا كان هو الكتاب هو الوحيد الذي ترجمه ونشره هذا المركز من تراث حلاق كله.
ولا يمكن أن ننسى الزمن الذي صدر فيه الكتاب، لقد كان زمن الاحتدام الضخم حول المستقبل، في إبان الربيع العربي ووصول الإخوان إلى السلطة في مصر وتونس، واحتمال وصولهما إليها في غيرها.. لقد شهدت هذه الفترة سعارا علمانيا محموما لنقض فكرة الدولة الإسلامية، يستوي في ذلك من اعتمد لغة هادئة أو من اعتمد لغة هائجة.
لقد زادَ هذا كلٌّه -العنوانُ والتوقيتُ- من رواج الكتاب وانتشاره، ولكنه شوَّه فكرته أيضا. أتصور أن الكاتب إذا خُيِّر بين رواج مع تشوه مثير للنقاش والجدل، وبين خفوت وانطماس فسيختار الأول.
كلمة "الدولة" معناها ملتبس، فهي في التراث الإسلامي تساوي الزمن أو العصر أو الحقبة، يقال: دولة بني أمية أو دولة بني العباس ويُقصد به زمانهم، فهي مشتقة من التداول (وتلك الأيام نداولها بين الناس).. ولكنها في المعجم السياسي المعاصر تشير إلى "جهاز الحُكْم" وإلى النظام السياسي.. ولهذا يفهمها المعاصرون العرب باعتبارها مردافا للحكم والسلطة والنظام.. إلخ!
بينما وائل حلاق يرفض استعمال هذا اللفظ "الدولة" إلا بمعنى "الدولة الحديثة" التي هي النسخة الغربية المعاصرة من شكل الحكم.. فالدولة عنده هي هذا المعنى، ويرفض بإصرار أن يُطلق لفظ الدولة على أي معنى آخر، حتى أنه اشتبك في أكثر من حاشية مع مستشرقين آخرين عبَّروا عن نظام الحكم الإسلامي بكلمة "دولة"، واشتبك مع نوح فيلدمان لاستعماله لفظ "دولة" لوصف نظام الحكم الإسلامي في كتابه "سقوط الدولة الإسلامية ونهوضها" مع أن طرحهما متقارب جدا إن لم يكن متطابقا.
برأيي أن هذا الإصرار على هذا المعنى الوحيد للفظ "الدولة" لا ضرورة له، ففي النهاية فإن المنادين بالدولة الإسلامية -مهما كان إيمانهم بإمكانية تلاقي نظام الحكم الإسلامي مع شكل الدولة الحديثة- يعرفون أنهم في سعيهم هذا يُعدِّلون تعديلا جوهريا في شكل النسخة الغربية المعاصرة من الحكم "الدولة الحديثة".. وبالتالي فليس الاشتباك حول اللفظ أمرا شديد الأهمية طالما نستطيع تمييز الفحوى والمضمون.
كذلك فإن استعماله لفظ "المستحيلة"، بدا لمن لم يقرأ الكتاب، وكأنه يُصدر بهذا حُكْما نهائيا على استحالة عودة نظام الحكم الإسلامي، وهذا المعنى جديرٌ بأن يثير حساسية كل مسلم، مع أنه أوضح صراحة في أكثر من موضع أنه لم يقصد هذا، ولكنه قصد إلى أن شكل نظام الحكم الإسلامي إن عاد للواقع ذات يوم فسيكون مغايرا ومخالفا لشكل الدولة الحديثة. كما أنه طرح فكرة الصعوبات الواقعية، إذ النظام العالمي بتركيبته الرأسمالية المعولمة القائمة على شبكة من الدول القومية القُطرية لن يسمح بقيام حكم إسلامي، وسينفق في هذا كل ما لديه من عنف هائل في سبيل تحطيم أي حركة تسعى إليه.
[3]
ذكرتُ أن الكتاب لم يُكتب لنا، وإنما كتب للجمهور الغربي أو لصناع القرار في الغرب، ومن أبرز الأدلة على هذا أنه أنفق وقتا طويلا في شرح أركان الإسلام -في الباب قبل الأخير إن لم تخني الذاكرة- ليشرح آثارها الأخلاقية على مجتمع المسلمين.
ولهذا فإن الكتاب ليس مفيدا للحركيين ولا لعموم المسلمين، هو مفيد لمساحة المثقفين والباحثين الذين يخوضون هذا السجال الفكري مع العلمانيين أو مع الغربيين، والذين يهتمون بجمع الأدلة في بيان عيوب الدولة الحديثة وتفوق النموذج الإسلامي.
بينما المسلم يتشرب المعاني المطروحة فيه بشكل طبيعي من خلال الكتاب والسنة وتراث المسلمين ومواعظ العلماء والدعاة.. بل يتشربها بطريقة أكثر عمقا وبساطة، بل -وهذا هو الأهم- يتشربها بالطريقة التي تحثه على العمل.
أنا شخصيا قبل عشر سنوات كتبتُ كتابا عن "منهج الإسلام في بناء المجتمع"، أشعر أحيانا حين أقرؤه بأنه تافه لا يطرح جديدا على المجتمع المسلم، وأحيانا أشعر أنه جيد جدا وأتعجب كيف كتبته قبل عشر سنوات، لم أكن قد اطلعت فيها على آلاف الأدلة الإضافية على فكرته الرئيسية، وأشعر بإلحاح أني في حاجة إلى إنتاج نسخة أخرى منه مشروحة ومزيدة تحتوي ما وقعتُ عليه في هذه السنين من الأدلة والإضافات.
ضربتُ المثل بنفسي هنا لكي أقول، وبدون أي محاولة تواضع، أن الشاب المسلم يستطيع ببضاعة قليلة مزجاة من الثقافة العامة أن يعتنق نفس الفكرة الرئيسية التي تبدو وكأنها مفاجئة للبيئة الثقافية يوما ما! وذلك لشدة وضوحها.. والقصد أن أقول: إن هذا الكتاب -كتاب حلاق- ليس مؤثرا أبدا في مسيرة أي حركة إسلامية، لأنها تعتنق فكرته بطبيعتها.. هو ربما كان مفاجئا لقومه ومفاجئا للبيئة الثقافية المرتبطة بالإنتاج الغربي.
حتى الحركات الإسلامية التي تبدو مؤمنة بالحداثة والدولة الحديثة، هي في حقيقة الأمر ليست كذلك، ولو أتيحت لها الفرصة الحقيقية لتطبيق نموذجها، فسينتج عنها بشكل تلقائي تغييرات جوهرية على نموذج الدولة الحديثة يُفرِّغها عمليا من محتواها العلماني، ويتدرج في التطبيق والتنفيذ إلى إنتاج صيغة معاصرة من نظام الحكم الإسلامي. حتى الغنوشي والعثماني -مع عميق بغضي لأفعالهما ورفضي التام لسياساتهما وأفكارهما- إذا أتيحت لهما فرصة تامة وارتفعت عنهما الإكراهات العلمانية والدولية لكانت النتيجة نسخة توفق بين الإسلام والحداثة، وستنتهي حتما إلى الإسلام لا الحداثة!.. على الأقل هذه قناعتي، ولست مستعدا الآن للجدال حولها.
[4]
يعد كتاب وائل حلاق هذا واحدا من الكتب التي أتعجب أن صاحبها لم يعتنق الإسلام.. إن الكتاب يمكن ببساطة أن نجعل عنوانه "الإسلام هو الحل" وسيكون هذا العنوان أكثر تعبيرا عن محتواه من هذا العنوان الحالي.
يصلح الكتاب أن يكون مرافعة ممتازة لصالح نظام الحكم الإسلامي في مقابل نموذج الدولة الحديثة، ولا أكاد أشك أن نشأة وائل حلاق القديمة في الشام وما بقي في ذهنه من ذكراها جعلته يقارن بوضوح بين المجتمع الأخلاقي الذي نشأ فيه وبين الحداثة القاتلة التي يحياها الآن.
إن الذين يقيمون في الغرب يذوقون بالفعل روعة المجتمع الإسلامي الأخلاقي المتكافل، بشرط أن يتخلصوا من عقدة النقص.. وهذا الأمر بدا كثيرا في إنتاج كثيرين من المستشرقين بل وفي إنتاج المسلمين الذين ذهبوا إلى الغرب إذا لم يفقدوا أنفسهم.. ولا يزال تعبير سيد قطب العبقري يرنّ في رأسي منذ قرأته، "أمريكا: تلك الورشة الضخمة الغبية"!
ويمكن في هذا السياق أن نطالع كتابات جوستاف لوبون وآنا ماري شيميل وزيجريد هونكه وعلي عزت بيجوفيتش وعبد الوهاب المسيري.. حتى إن بعض المستشرقين المتعصبين يندّ عنهم شيء كهذا أحيانا مثل جولدزيهر الذي كان يتنكر ليصلي مع المسلمين ورينان الذي كان منظر الصلاة يثير فيه الندم أنه لم يكن مسلما.
قرأت كثيرا من كتب المستشرقين عن سيرة النبي أو فصولا كتبوها عنه وتعجبتُ إلى درجة الحيرة: لماذا لم يُسلم هؤلاء؟!.. إن بعضهم كتب أمورا يعجز عن كتابتها بعض الدعاة والعلماء المسلمين، وما ذلك إلا لأن خبرتهم بـ "الجاهلية" الغربية سمحت لهم بالتقاط جوانب من عظمة الإسلام لا ينتبه لها المسلم.
أحسب أني بعد هذه السنين وصلتُ إلى بعض الجواب: إن منهج الوضعية العلمية السائد في الغرب منذ دخوله عصر العلمانية جعل كثيرا من الباحثين يرى أن مهمته تتوقف عند إتمام البحث بصورة عملية ممتازة، ولا يرى نفسه بعد ذلك مكلفا باتباع ما وصل إليه من الحق أو الخضوع له!
هذه النزعة الوصفية التفسيرية التي لا يتبعها عمل تسربت بقوة إلى مجتمعاتنا العلمية، صار كثير من الباحثون والأساتذة العرب رؤوسا كبيرة متضخمة ممتلئة بالأفكار، لكن لا نصيب لها من سلوكهم وعملهم! صار الباحث يرى عمله واقفا عند جمع المعلومات وتركيب الصورة وتقديم التفسير وربما تقديم بعض التوصيات، دون أن يرى نفسه مُطالبًا بالحركة في سبيل ما آمن به من هذه القناعات!
وهذا أمر مُدَمِّر.. وهو خلاف ما كان عليه حال العلماء في حضارتنا الإسلامية، حيث العلم يُطلب للعمل، وحيث لا يقبل من العالِم أن يخالف ما يقوله.. الآن بإمكان الطبيب أن يحاضر عن خطورة التدخين أو الخمر ثم هو يدخن أو يشرب الخمر، وبإمكان أستاذ الجامعة أن يحاضر عن الحقوق والحريات ثم هو نفسه ترسٌ في آلة استبداد بشعة، بل حتى الحقوقي يحاضرنا عن المرأة والتحرش ثم هو نفسه يزني ويغتصب ويتحرش!!
هذا الحال الذي ينفصل فيه العلم عن العمل، والعلم عن الأخلاق، مقبول في الزمن الغربي حيث المنهجية الوضعية (التي هي بنت العلمانية)، ولكنه مرفوض أشدَّ الرفض في ديننا ومنهجنا.
كتاب حلاق هذا هو واحد من طابور طويل من الكتب التي عرف أصحابها الإسلام ثم لم يعتنقوه.. فكيف يفعل هؤلاء أمام ضمائرهم؟ وكيف يكون حالهم أمام الله يوم القيامة؟!
[5]
كشف هذا الكتاب، عند صدوره، مأساة في حالتنا الثقافية العربية.. فلو امتدت يد إلى كتاب حلاق هذا فغيَّرت أسلوبه الأكاديمي الجاف، واستبدلت بعض صياغاته بأخرى فيها آيات وأحاديث وبعض العاطفة، ومدَّت بعض الأفكار على استقامتها، لتحول هذا الكتاب إلى تنظير جها دي ممتاز، ولصار طبعة جديدة موسعة من "معالم في الطريق" لسيد قطب، أو طبعة جديدة من كتاب تأسيسي حركي لجماعة جها دية!
هذا يخبرك كيف أن الفكرة حين يكتبها غربي باللغة الإنجليزية وبالأسلوب البارد تصير موضع حفاوة وتقدير، أو على الأقل مناقشة وتفكير، ثم كيف أن نفس هذه الفكرة حين يكتبها مسلم غيور تُجابَه بالإنكار والرفض والتنديد والتشنيع!!
إن نخبتنا الثقافية تشربت من أصول التفكير الغربي ما لم تتشرب عشر معشاره من القرآن والسنة، حتى صار ما يعجبنا لا يزيد عن أن يكون "بضاعتنا رُدَّت إلينا"!! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
December 1, 2020
كيف تتشكل صورة المسلمين في فرنسا؟ خبرة مستشرق فرنسي
في عام 2016 أصدر المستشرق الفرنسي فرانسوا بورغا كتابه "فهم الإسلام السياسي"، وفيه حاول أن يوجز رحلاته في الديار الإسلامية، حيث اكتشف هناك زيف الصورة التي يعتنقها الفرنسيون. واكتشف أيضا أن هذه الصورة ليست لمجرد ضعف الثقافة أو لأن الفرنسيين لا يعرفون إلا الغرب، بل لأن ثمة شبكة من المؤسسات السياسية والإعلامية والأكاديمية تعمل على ترويجها وفرضها وتثبيتها كصورة وحيدة. ونفس هذه الشبكة هي التي تُرَوِّج تحليلاتها وتفسيراتها وتقدم "الفهم الوحيد الصحيح" لما يحدث في بلاد المسلمين، ليس هذا فحسب، بل إنها تسعى سعيها المحموم لمطاردة أي صوت آخر يحاول أن يقدم صورة أخرى أو تحليلا آخر لما يجري هناك.
ومن ثَمَّ كان على المتحدث في شأن الشرق أن يلتزم بهذه الرواية الرائجة، فإذا تجرأ وقدَّم رواية أخرى تنصف المسلمين أو تحاول فهمهم، كان عليه أن يدفع الثمن، ومن الجدير بالذكر أن تهمة التعاطف مع الإسلام تساوي "باختصار: الخيانة"
نشر في مجلة المجتمع الكويتية، ديسمبر 2020
ص20، 22، 23.
ص18.
ص19، 25.
November 2, 2020
فرنسيون أنصفوا الإسلام
ومن بين طابور المستشرقين الفرنسيين الطويل خرج عدد قليل من أولئك الذين أنصفوا الإسلام ونبيه وحضارته، فمنهم من اصطفاه الله وكتب له الخير فأسلم واعتنق الدين، ومنهم من بقي على حاله.
وعموما فإن الكتابات المنصفة تصدر عن الغربيين بعد أن تنطوي صفحة الصراع المشتعل، حين ينتصرون في المعركة ويحسمونها لصالحهم، عندها لا يعود الشعور بالخطر قائما، وتصير الأمة المغلوبة كالجثمان الممدد أو الفريسة العاجزة، لا يُخشى منها، وعندئذ يمكن أن تبدأ دراستها بطريقة أكثر علمية وموضوعية، مثلما تجري دراسة الآثار في المتاحف، لا يستنكف أحد أن يعترف بعظمة حضارة قد دثرت وماتت.
لذلك فإن التأمل في تاريخ إنصاف الحضارة الإسلامية في الكتابات الاستشراقية سيفضي بنا إلى إدراك أن هذا الإنصاف لم يحصل إلا بعد العلو الغربي، وأما ما قبل ذلك فقد كان الجهر بإنصاف الإسلام أمرا خطيرا، فمن ذا الذي يجرؤ –ولو بدافع العلمية والموضوعية- أن يمتدح عدوه الذي يستشعر منه الخطر؟!.. إنه أمر لا يقوم به إلا أفذاذ الناس الذين يرفعون قدر الحق والحقيقة فوق كل اعتبار وكل مصلحة، ويكونون مستعدين لدفع الثمن الباهظ بمخالفتهم تيار السياسة وتيار الإعلام وتيار التحريض الشعبي. إن الذي ينطق بالحق في وقت الهزيمة والقهر وقلة النصير وشدة الخطر إنما هو في مرتبة عليا، بل هو في الإسلام "سيد الشهداء".
ومع هذا كله، ومع استيعابنا لهذه الظروف التي تسمح بالكلمة المنصفة، فإنه لا بد أن نُقَدِّر أيضا أولئك الذين أنصفوا ديننا ونبينا وتاريخنا، فلم يزل هذا الإنصاف مغامرة غير آمنة في كل الأحوال، لا سيما في فرنسا، ومن يتابع أعمال المستشرق المعاصر فرانسوا بورجا يرى بنفسه بعضا من هذه المعاناة التي يلقاها، والتهم التي يُرمى بها، ليس ذلك إلا لأنه جال كثيرا من بلدان العالم العربي ورأى الصورة التي تحجبها فرنسا، وتلمس التاريخ الذي لا يُدَرَّس فيها.
وبعض أولئك الذين حاولوا إنصاف الإسلام وحضارته ورسالته سلك مسالك متنوعة وحذرة في إزجاء المدح الواضح، وامتلأ حديثه بالاستدراك والاستثناء وطرح الاحتمالات، كأنه يحاول أن يجد طريقا لا يخون به العلم ولا يزعج به الحالة السائدة.
في هذه السطور القادمة التقطنا بعض هذه الشهادات المنصفة التي صدرت عن مستشرقين منصفين، وغرضنا منها أن نبين: أن الباحث إذا أخلص لوجه الحقيقة وتجرد لها فإنه سيصل بمشيئة الله إليها، حتى لو كانت بيئته وثقافته تنطلق من المعاداة.
1. تحدث المستشرق الفرنسي وعالم الاجتماع المعروف جوستاف لوبون عن الفتوحات الإسلامية فقال: «وكان يمكن أن تعمي فتوح العرب الأولى أبصارهم، وأن يقترفوا من المظالم ما يقترفه الفاتحون عادة، ويسيئوا معاملة المغلوبين، ويكرهوهم على اعتناق دينهم، الذي كانوا يرغبون في نشره في العالم ... فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين متسامحين مثل العرب، ولا دينا مثل دينهم... وما جهله المؤرخون من حلم العرب الفاتحين وتسامحهم، كان من الأسباب السريعة في اتساع فتوحهم، وفي سهولة اعتناق كثير من الأمم لدينهم ونظمهم ولغتهم، التي رسخت وقاومت جميع الغارات، وبقيت قائمة حتى بعد تواري سلطان العرب عن مسرح العالم»



