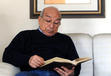فهمي هويدي's Blog, page 203
January 21, 2011
مناضلون بأثر رجعي
صحيفة الشرق القطريه السبت 18 صفر 1432 – 22 يناير 2011
مناضلون بأثر رجعي – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/01/blog-post_22.html
في الأسبوع الماضي بث التلفزيون التونسي تسجيلا لشيخ المدينة (عمدة العاصمة) حيا فيه ثورة الشعب التونسي العظيم التي نجحت في إزاحة الطاغية الأعظم ونقلت البلاد من ظلمات الاستبداد إلى نور الحرية،
وقبل ستة أسابيع فقط كان الرجل ذاته يتحدث في برنامج « قهوة تركية » الذي يبثه التلفزيون التركي الناطق بالعربية مشيدا بالقائد العظيم الذي انتشل تونس من ظلمة التخلف إلى نور الرقي والتقدم والنهوض،
لم يكن الرجل وحيدا في ذلك، ولكنه كان واحدا في طابور طويل من ،« المتحولين » الذين ظلوا طوال السنوات التي خلت يمجدون القائد العظيم ويتقدمون مواكب التهليل له، ثم صاروا يتقدمون الآن مواكب التهليل للثورة ويعبرون عن اعتزازهم بما أنجزه الشعب العظيم الذي أطاح بالطاغية الذي أذل البلاد والعباد،
قبل أشهر قليلة كان هؤلاء جميعا يتسابقون على تسجيل أسمائهم في قوائم المناشدات التي دعت إلى تعديل الدستور وإلغاء قيد السن لتمكين الرئيس بن على من ترشيح نفسه في انتخابات عام 2014 ، كي لا تغيب شمسه الوضاءة عن أرض تونس، ولكي لا يستشعر التونسيون اليتم بغيابه!
لقد قرأت تصريحات لبعض الفنانات والفنانين برروا فيها وضع أسمائهم ضمن المناشدين، قال أغلبهم فيها إن أسماءهم وضعت دون علمهم، وقال آخرون إنهم هددوا وأكرهوا على ذلك، واعترف آخرون بأن الخوف دفعهم إلى ذلك،
وأمثال هؤلاء جيش من الأدباء والشعراء والسياسيين والأكاديميين، وقد تحول هؤلاء الآن إلى مناضلين وطنيين فخورين بثورة الشعب وانتصاره على نظام القهر والفساد الذي ظل جاثما على كل الصدور لأكثر من عشرين عاما، جميعهم غسلوا أيديهم من التزلف للنظام السابق والتهليل له.
الحاصل في تونس رأيناه أيضا في أصداء الحدث في الإعلام العربي، ذلك أن النظام السابق أنشأ وزارة للاتصال الخارجي (ألغيت في الوزارة التي شكلت بعد سقوطه) كانت مهمتها إغواء الإعلاميين في الخارج ورشوتهم، عن طريق استضافتهم وإغراقهم بالكرم التونسي، لكي يشتركوا في حملة تمجيد النظام وتبييض صفحته،
ذلك إلى جانب نشر الإعلانات في الصحف العربية التي ما برحت تتحدث عن إنجازات عصر بن علي وفضائل نظامه، وأي قارئ للصحف العربية، خصوصا في مصر ولبنان، لابد أنه يذكر ما نشرته تلك الصحف من مقالات وإعلانات لم تقصر في عملية التهليل والتضليل.
لن أنسى في هذا الصدد أن اتحاد الصحفيين العرب عقد في العام الماضي دورة في تونس، التي حل فيها ضيفا على وزارة الاتصال الخارجي، وبعد انتهاء اجتماعاته التقى الرئيس بن على وفدا يمثل الاتحاد حيث قدم إليه هدية رمزية تقديرا لدوره في النهوض بالإعلام والدفاع عن الديمقراطية،
على الأقل فإن هذا ما ذكرته الصحف التونسية والعربية، التي نشرت صورة الرئيس وهو يستقبل الوفد، بعدما قامت وزارة الاتصال الخارجي بتوزيعها على كل من هب ودب ضمن سعيها إلى تسويق النظام وتجميل صورته،
وقتذاك (في 2 مايو 2010 ) كتبت تعليقا في هذا المكان كان عنوانه « ليس باسمنا » تحدثت فيه عن القمع الذي يمارسه نظام الرئيس بن على بحق التونسيين عامة والناشطين منهم بوجه أخص، كما أشرت إلى معاناة الصحفيين في عهده،
واعتبرت أن إهداء درع اتحاد الصحفيين العرب إليه بمثابة « فضيحة » ما كان لرئاسته أن تتورط فيها وخلصت إلى أن ذلك الدرع لا ينبغي له أن يقدم باسم الصحفيين العرب، ولكنه في أحسن فروضه يعبر عن موقف الذين قدموه دون غيرهم.
هذا التصرف من جانب رئاسة اتحاد الصحفيين العرب كان له وجهه الآخر، إذ جاء كاشفا عن أن التزلف إلى الحكام ليس مقصورا على تونس وحدها، ولكنه وباء يعم كل المجتمعات غير الديمقراطية، وللنخب حظها الوفير منه،
ذلك أن الأنظمة المستبدة التي لا تستند في شرعيتها إلى رضاء الناس وانتخابهم باتت ترتكز على فئتين هما العسكر والمثقفون.
الأولون يقمعون ويؤدبون، والآخرون يتسترون ويزينون ويضللون، إلا من رحم ربك بطبيعة الحال.
والفرق بين الاثنين أن العسكر يؤمرون فيطيعون، أما المثقفون فجرمهم أكبر لأنهم في أغلب الأحوال متطوعون ومنافقون، ومن ثم فلا عذر لهم، وحسابهم ينبغي أن يكون أكثر عسرا من الآخرين.
لا تثريب على من ضموا إلى قوائم المهللين دون علمهم، أو الذين أكرهوا على ذلك ولم يستطيعوا للإكراه ردا،
ولست أطالب المثقفين جميعا بأن يصبحوا مناضلين، لكنني أطالبهم فقط بألا يصبحوا منافقين، ذلك أنه إذا كان من أوجب واجباتهم أن يتصدوا للاستبداد والفساد ويفضحوهما، فإنهم يخونون أماناتهم إذا تستروا عليهما أو سوغوهما،
والمعيار الذي أرجو أن يلتزم به الجميع هو أن المثقف إذا لم يستطع أن يكون صوتا للحق فلا ينبغي له أن يكون سوطا للباطل .
والله أعلم .
....................................
January 19, 2011
لا تدفنوا الرؤوس في الرمال
صحيفة الشرق القطريه الخميس 16 صفر 1432 – 20 يناير 2011
لا تدفنوا الرؤوس في الرمال – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/01/blog-post_20.html
أصل الداء الذي ساعد على قتل النظام، قمعه الشديد لحرية الرأي والتعبير، وتكميمه لكل الأفواه، وسيطرته على كل وسائل الإعلام التي لم تكن تستطيع أن توجه نقدا لحكومته أو تصرفات بطانته.
وكانت نتيجة هذه السياسات استمرار الغليان تحت السطح.
بهذه القيود التي كبلت حرية التعبير حرم النظام نفسه من فهم أبعاد ما يجري تحت السطح، الذي ازدحم بمظاهر الزلفى والنفاق والحرص على ألا يسمع سوى ما يرضيه..
من ثَمَّ فإنه فقد جسور التواصل مع أجيال جديدة نهشت البطالة روحها وكرامتها، وكانت تلك الأجيال قوام الغضب العارم الذي اجتاح المدن.
قد يكون صحيحا أن النظام حمى البلاد من أخطار تنظيمات متطرفة عصفت بأمن الجيران. لكن الاستقطاب الحاد الذي عاشته البلاد طيلة السنوات الأخيرة، والاعتماد بالكامل على قوى الأمن فقط، والعداء الشديد لكل رأي مخالف حرم النظام من مساندة قوى عديدة كان يمكن أن تكون جزءا من جبهته في الحرب على التطرف.
حين يقرأ المرء الفقرات السابقة سيجد أنها تصف الأوضاع في أقطار عربية عدة. صحيح أن حالة تونس التي تتصدر نشرات الأخبار هي أول ما يخطر على البال، لكن القارئ سيلاحظ أيضا أن تونس لا تنفرد بتلك الصفات، لأنها تنطبق أيضا على أقطار عربية أخرى مغربية ومشرقية.
والحق أن الفقرات كتبت في التعقيب على ما جرى في تونس، ولا غرابة في ذلك، حيث لا نكاد نجد في الحيثيات التي أوردتها أية مفاجأة.
لكن المفاجأة الحقيقية أن تلك الحيثيات تم إيرادها للتدليل على أن ما حدث في تونس يمثل حالة متفردة خاصة لا تنطبق على غيرها من الدول.
والمفاجأة الأخرى أن الذي كتب هذا الكلام زميلنا الأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين المصريين (الأهرام 17/1/2011).
للدقة فإنه لم ينفرد بهذا الخطاب، لأن الصحف القومية تضمنت تعليقات أخرى عبرت عن نفس الموقف، وبذلت جهدا ملحوظا لإقناعنا بأن ما حدث هناك لا يمكن أن يتكرر في مصر، وإن الذين يلمحون إلى احتمال انتقال العدوى إلى مصر يعبرون عن تمنياتهم الخاصة، بحيث إن أملهم ذاك لا يختلف عن عشم إبليس في الجنة.
لا أعرف إن كان الترويج لفكرة خصوصية وتفرد الحالة التونسية تم تطوعا من جانب بعض كتاب الصحف القومية الذين التقوا عليها «مصادفة»، أم أن ثمة توجيها بذلك،
ولكن الذي أعرفه أن هناك فرقا حقا بين الأوضاع في تونس ونظائرها في مصر، ولكنه بخلاف ما ادعى زملاؤنا فرق في الدرجة وليس في النوع.
أعني أن ثمة أزمة واحدة في البلدين، ولكن تفاصيلها مختلفة في كل منهما.
أزمة الحريات وإقصاء الرأي المخالف واحدة،
والاعتماد على الأمن واحد.
واحتكار السلطة والتفاف المنافقين والمهللين حول القائمين على أمرها مشهود هنا وهناك.
أما الغلاء الذي طحن الناس والبطالة التي أذلتهم ودفعت بعضهم إلى الانتحار،
والفساد الضارب أطنابه في دوائر عدة،
ذلك كله يكاد يكون وباء لم يسلم منه كل منهما.
ولا أنكر أن ثمة فرقا لابد من الاعتراف به في درجة تكميم الأفواه ومصادرة الآخرين وقمعهم،
وربما كانت هناك فروق مماثلة في المجالات الأخرى،
ولكن تلك الفروق لا تلغي وجود أصل الأمراض. وتظل محصورة في درجة الإصابة بها،
وللعلم فثمة أوضاع في مصر أسوأ منها في تونس، أخص بالذكر منها حالة المجتمع المدني، الذي هو في تونس أقوى وأصلب عودا منه في مصر.
ونظرة على وضع اتحادات العمال والنقابات المهنية في البلد تشهد بذلك. إذ هي حاضرة هناك بقوة في حين أنها غائبة أو مغيبة تماما في مصر.
رغم أي تشابه يمكن رصده بين البلدين، فالذي لاشك فيه أن أحدا لا يتمنى لمصر أن تواجه ذات المصير الذي واجهته تونس. لكن التمني وحده لا يكفي، كما أن دفن الرؤوس في الرمال لا يفيد.
وللعلم فإن تجنب ذلك المصير ليس فيه سر ولا سحر، حيث طريق الاستقرار وكسب رضا الناس معروف للكافة.
وهذا الطريق لا ينفع إلا من خلال الإصلاح السياسي الحقيقي وليس المزور،
ومن خلال الالتزام بقيم الممارسة الديمقراطية وليس غشها أو الالتفاف عليها.
والعبر في هذه الحالة عديدة وماثلة بين أيدينا. لكن المشكلة تكمن في كثرة العبر وندرة المعتبرين.
إن الذين لا يتعلمون من دروس التاريخ ينبغي ألا يلوموا إلا أنفسهم إذا ما ضاقت بهم الشعوب فانتفضت وألقت بهم في مزبلة التاريخ.
.........................
January 18, 2011
العصابة لم تغادر
صحيفة الشرق القطريه الأربعاء 15 صفر 1432 – 19 يناير 2011
العصابة لم تغادر – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/01/blog-post_19.html
أرجو ألا نخطئ في قراءة المشهد التونسي، فتنسينا الفرحة بما جرى أن الذي تمت الإطاحة به رئيس العصابة ولكن العصابة ذاتها ما زالت موجودة ومتمكنة من مقدرات البلاد.
ولا أخفي أن في نفسي شيئا من استخدام مصطلح «العصابة»، فتلك ليست لغتي في التعبير، لكني سمحت لنفسي بذلك بعدما شاع الوصف في وثائق «ويكيليكس» التي تحدثت عن «المافيا» التي ظلت قابضة على الزمام في تونس طوال سنوات حكم الرئيس السابق بن علي.
لقد قلت في مقام آخر:
إن الاستبداد لا يخرب الحاضر فقط ولكنه يخرب المستقبل أيضا.
ذلك أنه حين يطول به الأجل في السلطة فإن القائمين عليه يسعون إلى تفكيك مؤسسات المجتمع وأجهزة الإدارة وإعادة تركيبها بحيث تتحول في نهاية المطاف إلى أدوات لبسط الاستبداد والتمكين له.
وفي مسعاهم ذلك فإنهم يستأصلون بدائلهم أولا بأول، بحيث ينغلق عليهم الأفق، ويظل استمرارهم هو الخيار الوحيد المطروح على الكافة.
في وصفه لطبائع الاستبداد، ذكر عبد الرحمن الكواكبي في كتابه الشهير الذي حمل نفس العنوان ما يلي:
إن الحكومة المستبدة تكون مستبدة في كل فروعها ومراتبها التي يقف المستبد الأعظم على رأسها.
وأعوان المستبد الأعظم ورجاله لا تهمهم الكرامة وحسن السمعة، إنما غاية مسعاهم أن يبرهنوا لمخدومهم بأنهم على شاكلته وأنصار لدولته. وبهذا يأمنهم المستبد ويأمنونه، فيشاركهم ويشاركونه.
وهذه الفئة المستخدمة يكثر عددها ويقل حسب شدة الاستبداد وخفته. فكلما كان المستبد حريصا على العسف احتاج إلى زيادة جيش المتمجدين العاملين له المحافظين عليه.
واحتاج إلى مزيد من الدقة في اتخاذهم من أسفل المجرمين الذين لا أثر عندهم لدين أو ذمة.
واحتاج لحفظ النسبة بينهم في المرتبة بالطريقة المعكوسة. وهي أن يكون أسفلهم طباعا وخصالا أعلاهم وظيفة وقربا.
ولهذا لابد أن يكون الوزير الأعظم للمستبد هو اللئيم الأعظم في الأمة. ثم من دونه لؤما، وهكذا تكون مراتب الوزراء والأعوان في لؤمهم حسب مراتبهم في التشريفات والقربى منه ــ انتهى الاقتباس.
لسنا نضيف جديدا إذن، فقد قالها الكواكبي قبل أكثر من مائة عام منبها إلى أن المستبد الأعظم (زعيم العصابة) يختار أعوانه ممن هم على شاكلته، وهؤلاء يتوحدون معه بمضي الوقت بما يؤدي إلى مأسسة الاستبداد، بمعنى إضفاء الصبغة المؤسسية عليه، بما يحول أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة إلى أذرع له،
لذلك تصبح عملية اقتلاع الاستبداد وطي صفحته أمرا بالغ الصعوبة، وربما تتحول تلك العملية إلى معركة يسقط فيها الضحايا، لأنه بعد رحيل المستبد الأعظم فإن وجود ومصير مؤسسة الاستبداد التي ارتبطت به يصبح في خطر محقق. وهو ما يدفعها إلى خوض معركتها الأخيرة بشراسة شديدة، لأن الأمر بالنسبة لها يصبح اختيارا بين الحياة أو الموت.
الحاصل في تونس الآن نموذج لذلك، فحزب السلطة (الدستور الحر) محتكر لها منذ أكثر من نصف قرن، في عهد «المجاهد الأكبر» الحبيب بورقيبة، الذي اكتسب شرعيته من كونه بطل الاستقلال.
وفي عهد خلفه زين العابدين بن علي الذي استولى على السلطة في عام 1987 بعدما كان وزيرا للداخلية. ومنذ اللحظة الأولى حول تونس إلى سجن كبير. وجعلها نموذجا للدولة البوليسية التي وظفت كل أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع لتكريسها وتثبيت أركانها..
من ثَمَّ تحولت تلك الأجهزة والمؤسسات إلى رموز للاستبداد، وصار القائمون عليها أذرعا وعيونا للمستبد الأعظم.
ورغم أن الإطاحة برأس الاستبداد تعد إنجازا عظيما، إلا أن ذلك لا يعد كافيا، لأنه حين ذهب، فإن مؤسسة الاستبداد التي صنعها على يديه ظلت قائمة.
صحيح أن بعض أركان تلك المؤسسة جرى استبعادهم (وزير الداخلية ومسؤول أمن الرئاسة مثلا) إلا أن ذلك لا يغير من حقيقة توحد الحزب الحاكم مع أجهزة الإدارة، وكون الذين تتابعوا على إدارة البلد طوال الـ23 سنة الماضية كانوا ولا يزالون أعوانا للمستبد الأعظم.
من ثَمَّ فإن استمرارهم في مواقعهم يعني أن العصابة مازالت قائمة وأن مكتسبات الثورة في خطر.
وفي هذه الحالة ينبغي ألا نستغرب إذا وجدنا أنهم يحنون إلى زمانهم ويحاولون استعادته بصورة أو أخرى.
هذا التحليل يعني أن صفحة المستبد الأعظم لم تطو بعد، وتشكيل الحكومة التونسية الجديدة يؤكد على ذلك بمنتهى الوضوح.
وهو يعني أيضا أننا ينبغي لنا ألا نعول أو أن نطمئن طالما بقي للعصابة حضور في الوضع المستجد.
لذلك فإنني أدعو إلى الترقب والحذر، وتأجيل الفرحة الكبيرة حتى نتأكد من أنه لم يعد للعصابة دور في إدارة البلد.
وأرجو ألا ننتظر كثيرا لكي نعيش الفرحة الأكبر التي تحل حين تختفي العصابات المماثلة في كل بلد.
.....................
January 17, 2011
السودان في مواجهة الزلزال – المقال الأسبوعي
صحيفة الشرق القطريه الثلاثاء 14 صفر 1432 – 18 يناير 2011
السودان في مواجهة الزلزال – فهمي هويدي – المقال الأسبوعي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/01/blog-post_18.html
ذهبت إلى الخرطوم متصورا أنني سأشارك في تقديم واجب العزاء لأهلها في انفصال الجنوب، ففوجئت بأن بعضهم أطلق زغاريد الفرح ونحر الذبائح احتفاء بالمناسبة!
ــ1ــ
ظللت طوال الوقت غير مستوعب فكرة انشطار السودان. واكتشفت لاحقا أنني لم أكن وحيدا في ذلك، حيث عبر لي بعض المسؤولين السودانيين الذين لقيتهم، في المقدمة منهم نائب الرئيس علي عثمان أن الانفصال لم يخطر لهم على بال يوما ما، وأنهم فوجئوا ببروز فكرته في الآونة الأخيرة.
لكني صدمت بعد دقائق من خروجي من مطار الخرطوم، حين قال سائق السيارة التي حملتني في رده على سؤال لي.
إنه يشعر الآن أن هما انزاح من على قلبه، ووجدت صدى لهذا الشعور في تصريح أخير للرئيس عمر البشير قال فيه إن الجنوب كان عبئا على الشمال منذ الاستقلال.
اثار انتباهي في هذا الصدد أن مجموعة من المثقفين السودانيين تبنوا الفكرة منذ أربع سنوات، وأنشأوا لهذا الغرض تجمعا أسموه منبر السلام العادل، وأصدروا صحيفة «الانتباهة» التي عبرت عن هذا الموقف وروجت للانفصال، معتبرة أن حدوثه يفتح الأبواب واسعة لتفرغ السودان الشمالي للنهوض والتنمية والتقدم.
وأثار دهشتي أن هذه الدعوة لقيت رواجا واسعا، حتى أن توزيع الجريدة قفز إلى مائة ألف نسخة يوميا، بفارق 70 ألف نسخة عن أعلى صحيفة أخرى في البلاد. وهو معدل للتوزيع لم يعرفه السودان في تاريخه.
وفوجئت بأن مؤسس هذا المنبر ورئيس مجلس إدارة الصحيفة، المهندس الطيب مصطفى يمت بصلة قرابة للرئيس البشير، حيث يعد من أخواله. وقيل لي إن الرجل فقد أعز أبنائه في الحرب ضد التمرد الجنوبي،
كما علمت أن المجموعة التي تدير المنبر وتصدر الصحيفة تضم عددا من الوزراء والمسؤولين الحاليين والسابقين.
وفي اليوم الذي بدأ فيه الاستفتاء (9 يناير) وبدأت فيه إجراءات الانفصال. وقد عبر أعضاء المنبر عن فرحتهم بنحر جمل وثور أمام مقرهم.
حين قلت إن الزيادة الصاروخية في توزيع صحيفة «الانتباهة» بمثابة استفتاء للجماهير الشمالية لصالح الانفصال. تحفظ البعض على الفكرة بقولهم إن الصحيفة لها جمهورها في بعض الأوساط حقا في الشمال، ولكنها مقروءة أيضا في «جوبا» عاصمة الجنوب، الأمر الذي أسهم في زيادة توزيعها.
ناقشت الأمر مع من لقيتهم من السياسيين والمثقفين، وكانت خلاصة ما خرجت به أن الترحيب بالانفصال حاصل بدرجة أكبر بين قطاعات الشباب الذين دعوا إلى الحرب في الجنوب إلى جانب القوات المسلحة.
وهؤلاء المدنيون قتل ٢٣ ألفا منهم في المعارك ضد المتمردين، الأمر الذي رسَّب لديهم شعورا بالنفور والمرارة. وهذه المشاعر لا أثر لها في أوساط النخبة التي لا تزال تعتبر الانفصال كارثة وطنية وإستراتيجية.
وبعض الذين أيدوه متأثرون إلى حد كبير بالحملة الإعلامية والسياسية التي شنها بعض المسؤولين الجنوبيين ضد الشمال في الآونة الأخيرة. إذ عمدوا إلى التشهير بالشماليين وادعوا أنهم كانوا مواطنين من الدرجة الثانية وأنهم عانوا في ظل سنوات الوحدة من العبودية والرق وغير ذلك من المظالم التي كان فيها من التعبئة والتحريض على التصويت لصالح الانفصال، أكثر مما فيها من التصوير الأمين للواقع.
ــ2ــ
إذا كان البعض قد عبر عن الارتياح والحفاوة بالانفصال عن الجنوب، فإن الكل شركاء في الصخب الراهن الذي تشهده الخرطوم، التي هي مدينة بطبيعتها مسيَّسة (رسميا هناك 82 حزبا مسجلا) ولك أن تتصور الطنين الذي يمكن أن تحدثه بيانات وتراشقات تلك الأحزاب في الظروف العادية، وكيف يمكن أن يتضاعف ذلك الطنين أمام ظرف غير عادي ومصيري مثل حدث الانفصال، الذي أزعم أنه بدا صاعقة لم تكن في الحسبان سقطت فوق رؤوس الجميع خلال الأشهر الأخيرة.
صحيح أن الجميع مشغولون بتحديات الحاضر والمستقبل، إلا أن الكلام ينعطف في كل مناقشة ــ مما شاركت فيه على الأقل ــ على الماضي، الذين يرون فيه جذور أزمة الحاضر. فلا أحد يستطيع أن ينسى أن الإنجليز بعد احتلالهم للسودان وضعوا الأساس لشطر الجنوب عن الشمال. حيث لم يكفوا عن محاولة إضفاء هوية متميزة لكل منهما.
آية ذلك أنهم أصدروا في عام 1922 قانون المناطق المقفلة الذي في ظله لم يسمح للشماليين بدخول الجنوب إلا بإذن خاص.
وفي ظل الإقفال طلب من المسلمين تغيير أسمائهم وثيابهم وإلا تعرضوا للجلد. وأطلقت يد بعثات التبشير لتحويل الوثنيين إلى الكاثوليكية من خلال المدارس التي أنشأوها خصيصا لهذا الغرض.
وهذه التغذية المبكرة غرست بوادر الحساسية بين الجنوبيين والشماليين، وكانت لها أصداؤها في تمرد الجنوبيين في أحد معسكرات الجيش عام 1955، قبل أربعة أشهر من إعلان الاستقلال في 1956.
ولا أحد يختلف حول وجود أصابع إسرائيل في أوساط الجنوبيين منذ السنوات الأولى التي أعقبت الاستقلال، على النحو الذي سبق أن فصَّلت فيه
في مرة سابقة
، وذكرت أن الضغط على مصر هدفه الأساسي.
أحد الأسئلة التي أثرتها خلال المناقشات ما يلي:
هل كان يمكن الحيلولة دون الانفصال،
ولماذا انتقل الكلام من ترتيب أمر الوحدة إلى المطالبة العلنية بالانفصال؟
في هذه النقطة ذكر أكثر من مسؤول أن السودان وقف وحيدا أمام العاصفة، وخاض تجربة إنقاذ الوطن من التقسيم وحده.
كما أنه مدرك أنه سيخوض معركة ما بعد الانفصال وحده أيضا، بغير معونة من أي طرف عربي، في حين أن الولايات المتحدة والدول الغربية ومن ورائها إسرائيل ويضاف إليهم الفاتيكان كل هؤلاء كانوا يدفعون الأمور باتجاه الانفصال، وإلى جانبهم في ذلك العديد من المنظمات العالمية.
في الإجابة عن الشق الأول من السؤال قالوا إن السودان ظل مشغولا بالحرب طوال الوقت. وأنه ظل يستجيب لطلبات الجنوبيين في المفاوضات أملا في أن يشبع ذلك رغباتهم ويجعلهم يستبعدون احتمال الانفصال.
وكانت ردود الأفعال إيجابية بصورة نسبية من قيادات الجنوبيين، وفي المقدمة منهم جون قرنق الذي ظل يتحدث عن فكرة «السودان الجديد» الموحد وخلفه سيلفاكير الذي ظل يردد في كل مناسبة أنه سيصوت للوحدة.
فيما خص التحول من السودان الموحد أو الجديد إلى انفصال الجنوب سمعت من أكثر من مصدر مسؤول رفيع المستوى أن الطرف الذي لعب دورا رئيسيا في ذلك التحول كان موسيفيني رئيس أوغندا، الذي تربطه صلات وثيقة للغاية مع إسرائيل.
في هذا الصدد تقول الرواية المتواترة إن موسيفيني لم يكن مقتنعا بفكرة السودان الجديد التي تبناها جون قرنق، ودعا فيها إلى السعي لإقامة دولة موحدة في السودان، علمانية وغير عربية بالضرورة، وأن الرجلين اختلفا حول جدوى وإمكانية تنفيذ الفكرة في آخر لقاء بينهما في كمبالا،
وفي أعقاب تلك الزيارة غادر جون قرنق أوغندا على طائرة سقطت به وقتل فيها. وهناك قرائن تدل على أن موسيفيني له يد في عملية القتل، التي كان من نتائجها تولي سيلفاكير قيادة الحركة الشعبية.
تضيف الرواية أن سيلفاكير زار كمبالا في العام الماضي وناقشه موسيفيني في موقفه الذي كان يعلن فيه تمسكه بالوحدة.
وإن الرئيس الأوغندي حذره من مصير جون قرنق إذا تخلى عن فكرة الانفصال، وهو ما اعتبره سيلفاكير تهديدا له بالقتل كما ذكر لبعض خاصته،
من ثَمَّ فإنه خشي على نفسه من ذلك المصير، وقرر أن يتراجع عن موقفه، خصوصا أنه كان يواجه ضغطا داخليا في ذات الاتجاه من بعض قادة الحركة الذين كانوا انفصاليين من البداية. ونقل عنه وقتذاك قوله في حديث علني إنه إذا قتل فعلى رفاقه أن يأخذوا بحقه.
تضيف الرواية أنه بعد ذلك اللقاء مع الرئيس الأوغندي، ذهب سيلفاكير إلى نيروبي ومنها إلى واشنطن، وهناك أعلن أنه سيعطي صوته لانفصال الجنوب.
ــ3ــ
حسب اتفاقية السلام التي وقعت في عام 2005، أعطيت مهلة حتى سنة ٢٠١١ لاختيار إمكانية إقامة وحدة جاذبة بين الشمال والجنوب، بعدها، يجري استفتاء بين الجنوبيين لتقرير مصيرهم،
وإذا صوت 60٪ منهم للانفصال تعطى فترة انتقالية مدتها ستة أشهر تنتهي في يوليو القادم، تقوم بعدها الدولة الجديدة في الجنوب. إلا أن المسؤولين في الخرطوم يرون أن تلك الفترة ليست كافية ويقولون في هذا الصدد إن ثمة 12 قضية متفجرة معلقة بين الشمال والجنوب يمكن أن تؤدي كل واحدة منها إلى إشعال نار الحرب بين الجانبين. وهذه القضايا الاثنتى عشرة يستحيل حسمها في تلك الفترة القصيرة.
وهي تتمثل في الحدود التي تمتد بطول 2300 كيلو متر وعلى جانبيها يعيش نحو عشرة ملايين شخص أغلبهم رعاة يتنقلون بين الجانبين على مدار السنة وراء الماء والكلأ،
والمياه التي لم يتحدد نصيب كل طرف منها بعد،
وعبء الديون التي تبلغ 40 مليار دولار وقد حملت على السودان الموحد من قبل (كان بعضها يمول مشروعات الجنوب).
والبترول الذي يحصل الشمال عليه نصف عائداته ويفترض أن تتوقف بعد إنشاء دولة الجنوب الجديدة رسميا،
الحساسيات والتوترات الدائمة في أبييه بين قبيلتي المسيرية (العربية) ودينكا نقول،
أوضاع المسلمين في الجنوب الذين يمثلون 20٪ من سكانه، (الحركة الشعبية أغلقت فرع جامعة أم درمان الإسلامية في جوبا)... إلخ.
لا يقف الأمر عند الملفات العالقة بين الشمال والجنوب، لأن كل طرف له مشكلاته الداخلية الدقيقة. ذلك أن نجاح الحركة الشعبية في إقامة دولة الجنوب والاستقلال عن السودان قد يكون مغريا لجماعات أخرى في الشمال لكي تسير على ذات الدرب.
وعلى الطاولة الآن ملف دارفور، لكن هناك جماعات أخرى تنتظر في جبال النوبة والنيل الأزرق وشرق السودان.
بالمثل فشبح الصراعات على السلطة في الجنوب لا يزال قائما سواء بين زعامات قبيلة الدنكا، حيث انشق جورج أطور عن قيادة الجيش الشعبي، أو بين الدنكا والقبائل الأخرى التي ترفض الخضوع لسلطات مثل النوبر والشلك.
يتحدثون في الخرطوم أيضا عن قلق الدول المجاورة من انفصال الجنوب، لأن ذلك يفتح الباب لمطالبة الجماعات الإثنية في تلك الدول بتقرير مصيرها. وهو الحاصل في إثيوبيا مثلا التي ينص دستورها على حق تقرير المصير بما قد يحرك مشاعر قبائل الأوقادين والأورمو نحو احتذاء حذو الجنوبيين.
ــ4ــ
قلت إن السودان بعد عدته لمواجهة التحديات القادمة وحيدا، بعدما علمته التجربة أنه لا ينبغي له أن ينتظر عونا من الأشقاء، خصوصا مصر التي لابد أن يصيبها بعض رذاذ الحاصل في السودان يوما ما،
وقد سمعت من أكثر من مسؤول عتبا على مصر لأنها لم تستخدم ثقلها لترجيح كفة الوحدة، وسارعت إلى التسليم بالانفصال وتأييده.
وهمس في أذني أحدهم منتقدا تصريح وزير الخارجية المصري السيد أحمد أبو الغيط الذي قال فيه إن دولة الجنوب ستأخذ نصيبها من المياه من حصة الشمال.
وذكر محدثي أن كلام السيد أبو الغيط أثار امتعاض الخرطوم، لكنها آثرت ألا تدخل في مشكلة مع مصر بسببه.
ما أقلقني في المشهد السوداني أن خطى الوفاق الوطني الداخلي بين أحزابه وجماعاته السياسية لا تتقدم بالصورة المرجوة، حيث هناك شد وجذب بين حزب المؤتمر صاحب الأغلبية في البرلمان وبين الأحزاب الأخرى التي دخلت 17 حزبا منها فيما سمي تحالف قوى الإجماع الوطني، علما بأن صلابة وتماسك الجبهة الداخلية هما العنصر الأهم في تمكين السودان من مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.
لكن بعض الساسة يكتفون أحيانا بالنظر تحت أقدامهم ويظنون أن استمرارهم في مواقعهم وليس الإجماع الوطني هو السبيل الأجدى لتأمين الوطن.
وقد فهمت أن بعض العقلاء يحاولون الآن تجاوز هذا الموقف والتنبيه إلى مخاطر اختزال الوطن في الذات.
ادعوا لهم بالتوفيق.
.....................
January 16, 2011
أكاذيبهم التي انفضحت
صحيفة الشرق القطريه الاثنين 13 صفر 1432 – 17 يناير 2011
أكاذيبهم التي انفضحت – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/01/blog-post_17.html
انتفاضة الشعب التونسي لم تكن زلزالا سياسيا عالي الدرجة فحسب، ولكنها مثلت لنا صدمة ثقافية أيضا.
دعك من أنها جاءت تصديقا للمقولة الشائعة في خطابنا السياسي التي تتحدث عن النوازل والمفاجآت التي نتوقعها من الشرق فإذا بها تداهمنا من الغرب.
إذ الأهم أننا كنا قد تصورنا أننا ودعنا عصر التحولات الانقلابية التي تثور على الأوضاع المهيمنة، حتى كاد اليأس يدب في قلوبنا من إمكانية تغيير الواقع، بعدما عاشت المنطقة العربية في حالة من الجمود السياسي لأكثر من عقدين من الزمان، رغم توافر أسباب الانفجار الشعبي في أكثر من بلد عربي.
وكنت أحد الذين دأبوا على القول بأنه طالما أنه لم يعد الموت السريري مؤديا بالضرورة إلى التعجيل بحلول أجل الوفاة، وطالما أنه من الممكن أن يبقى المريض في غرفة الإنعاش لعشر أو خمس عشرة سنة معتمدا على الأجهزة والأنابيب التي تسمح باستمرار تشغيل القلب، فإن الوضع يمكن أن ينطبق على السياسة أيضا، بحيث يظل المجتمع مسكونا بالغضب ومهيأ للانفجار لفترات مماثلة، دون أن ينفجر بالفعل، نظرا لجبروت الدولة الحديثة وإزاء ما توافر لها من إمكانيات غير مسبوقة للقمع والقهر.
ولئن صح ذلك بالنسبة لأغلب الدول العربية، فهو أصح فيما خص تونس، وهو البلد الصغير الذي يسكنه عشرة ملايين نسمة، ويعيش منذ نحو ربع قرن في قبضة نظام بوليسي شديد القسوة والشراسة، استخدم أبشع الأساليب لقهر الناس وترويعهم.
من ثَمَّ كانت المفاجأة أن الانتفاضة وقعت، وفي البلد الذي ظننا أنه آخر مكان يمكن أن ينفجر فيه غضب الناس، على نحو يسقط النظام البوليسي ويطوي صفحته إلى الأبد.
لنا في شأن ما حدث هناك كلام آخر. لكني معني في اللحظة الراهنة بما أحدثته المفاجأة من صدمة ثقافية، هدمت سلسلة الأفكار المغشوشة التي جرى الترويج لها خلال السنوات الأخيرة لتثبيط الناس وإقناعهم بأن الأوضاع القائمة هي قدرهم الذي لا فكاك منه.
من ثَمَّ فخيارهم الوحيد أن يرضوا بالمقسوم والمكتوب وأن يتكيفوا مع ما هو قائم، بمعنى أن يتغيروا هم لأنه لا أمل في تغيير الأوضاع القائمة.
لقد بذل جهابذة الموالاة ومنظرو النظام جهدا كبيرا لمحو فكرة الثورة الشعبية من الأذهان، حتى باتت تلك الفكرة موضوعا دائما للتندر من جانبهم.
وظل خطاب أولئك الجهابذة يلح على ضرورة التحرك من خلال القنوات والمنابر المزيفة التي اصطنعتها الأنظمة، بحيث تظل الدعوة إلى التغيير تحت رقابتها وسيطرتها،
ولكن الذي حدث في تونس بدد تلك الأفكار وأعاد إلى الأذهان بقوة فكرة التغيير الذي تفرضه الجماهير رغم الانسداد السياسي، أي من خارج الأطر والقنوات الخاضعة للرقابة والتوجيه الرسميين.
وأثبت أن إرادة الجماهير تستطيع أن تفرض نفسها، وأن تتحدى جبروت الأنظمة وسلطانها، إذا ما تسلحت بالتصميم، وكانت مستعدة لدفع ثمن موقفها الرافض للاستبداد.
على صعيد آخر فإن بعض المنظرين والباحثين ما برحوا يكررون على أسماعنا أن الجماهير لا تتحرك دفاعا عن الديمقراطية التي لا تشكل مطلبا أساسيا لها، ولكنها تتحرك فقط دفاعا عن احتياجاتها المعيشية، ولطالما استند هؤلاء إلى استطلاعات وقياسات للرأي دسُّوها علينا واستخلصوا منها أن شوق الناس إلى الحرية والكرامة أقل مما يتصور المثقفون،
ولكن مظاهرات تونس أعادت الاعتبار إلى قيم الحرية والكرامة الوطنية، وكان ذلك واضحا في اللافتات التي رفعت وظلت نداءاتها تركز على قضية الحرية وتندد بالاستبداد بكل صورة.
كذلك استهان أولئك الجهابذة بمقومات الهوية ورياح التغريب التي تعصف بمجتمعاتنا. ثم اكتشفنا أن تلك الاستهانة كانت من الأسباب التي فجرت غضب الناس وأثارتهم ضد النظام. جسدت ذلك الغضب على سبيل المثال كلمات أغنية مغنى «الراب» الذي اتهم نظام الجنرال بتضييع الشباب وضرب انتمائهم العربي والإسلامي.
قال لنا الجهابذة أيضا إن العلمانية هي الحل، وإنه لا ديمقراطية بغير علمانية، واختزلوا مشكلتنا في مادة الدستور التي تنص على أن الإسلام دين الدولة. ووجدنا أن كل ذلك توفر للنظام التونسي، ولكنه لم يؤد إلى شيء مما ادعوه.
فنظام السيد بن علي كان صارما في علمانيته التي قادت البلاد إلى جحيم الظلم وليس إلى سعة الديمقراطية الموعودة وإلى الاستبداد وليس الحرية.
كما أن دستور تونس خلا من أي إشارة إلى الإسلام كدين للدولة. لكن ذلك لم يحل شيئا من مشاكل المجتمع، ولا حال دون تفاقم أزمات البلد وتفجير غضب الناس.
لقد أطاحت ثورة الجماهير التونسية بالنظام المستبد حقا، لكنها أيضا فضحت سلسلة الأكاذيب التي يروج لها بعض المثقفين لتخدير الناس وتيئيسهم.
(للكلام بقية بعد غد بإذن الله).
..........................
January 15, 2011
مشكلة أن تكون نزيها
مشكلة أن تكون نزيها – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/01/blog-post_16.html
لن ترحمك الحكومة إذا كنت معارضا سياسيا،
ولن يرحمك المثقفون إذا كنت نزيها ومتجردا،
والأولى فهمناها وحفظناها جيدا.
أما الثانية فقد باتت بحاجة إلى تحرير، خصوصا في الأجواء الراهنة بمصر. المشحونة بالانفعالات والحساسيات، والمسكونة بقدر هائل من الغضب والحزن.
تلك خلفية دفعت كثيرين إلى إبداء مشاعر التضامن والتعاطف مع ضحايا المذبحة وذويهم، وهو أمر مشروع ومطلوب اكتفى به البعض،
في حين أن آخرين رأوا في المذبحة أنها ليست فاجعة أصابت فئة بذاتها دائما هي أيضا بمثابة طعنة في قلب الوطن. من ثم فإن قلوبهم كانت مع الضحايا حقا، في حين ظلت أعينهم معلقة بخريطة الوطن.
ومن موقعهم ذاك تعاملوا مع المشهد وتداعياته بقدر أكبر من التوازن والعقلانية، وبقدر أقل من الاندفاع العاطفي. وهو ما مكنهم من أن ينبهوا إلى الأخطاء التي وقع فيها الجميع، الحكومة والمسلمون والأقباط.
تحدثوا عن ضعف الحكومة وتراخيها الأمني، وعن تعصب بعض المسلمين وجنوح بعضهم إلى التطرف والإرهاب، وعن استقواء الكنيسة القبطية ورياح التعصب التي هبت على بعض أركانها ورعاياها.
هذا التجرد لم يعجب قطاعات من المثقفين، ولم تتعود عليه الجماهير المفتقدة إلى ثقافة التجرد. إذ لم تعد ترى من الألوان غير الأبيض والأسود، بحيث أصبح الناس عندهم إما مع أو ضد.
غاب عن هؤلاء وهؤلاء أن الواحد يمكن أن يكون مع طرف آخر وينتقده، وأن هناك فرقا بين التعاطف والتحيز.
والتعاطف يسمح بالنقد في حين أن التحيز لا يحتمله.
والتعاطف يسمح لك بأن ترى الحدث في ضوء الظروف والمصالح المحيطة به،
أما التحيز فإنه يضيق من زاوية النظر، بحيث يحصره في الحدث منفصلا عن محيطه.
ليس لي أن أتحدث عن النوايا، فضلا عن أنني لا أشك في إخلاص وصدق المثقفين الذين انفعلوا بما جرى ــ وبعضهم مسلمون محترمون ــ فتحاملوا على المسلمين وضاقت صدورهم بالنقد الذي وجه إلى الكنيسة القبطية،
ولأنهم ذهبوا في تعاطفهم إلى حد التحيز، فقد شنوا هجوما قاسيا على الذين اختاروا أن يقفوا في الوسط وأن يتجردوا في التعبير عن آرائهم، حين شغلوا بالوطن ومستقبله واستعلوا فوق مشاعر الطائفة.
ولا أريد أن أقلل من قدر مشاعر الغيرة على الطائفة. واعتبرها مشاعر نبيلة ومقدرة: لكننا لا ينبغي أن نوجه أصابع الاتهام إلى من عبروا عن غيرتهم على الوطن أيضا.
إنني لا أفهم مثلا لماذا نحتمل نقدا لرئيس الدولة والحكومة وللرموز والجماعات والمؤسسات الإسلامية، في حين ينتفض البعض غضبا إذا وجه أي نقد للكنيسة الأرثوذكسية ورئيسها.
ولماذا يعد ذكر بعض الأخطاء، التي تمس هيبة الدولة إخلالا بالوحدة الوطنية، كأن كتمانها والمداراة عليها وتحويلها إلى قنابل موقوتة يعزز الوحدة ويحميها،
ولماذا تضيق صدور البعض إذا حاولنا أن نعطي مذبحة الإسكندرية حجمها الحقيقي بلا زيادة أو نقصان، فاعتبرناها جريمة بشعة حقا، ولكنها حدث استثنائي في التاريخ المصري المعاصر. فلا مصر صارت كالعراق، ولا هي تحولت إلى معسكرات وطوائف مثل لبنان، ولا «القاعدة» هيمنت على مقدراتها واستولت على عقول شبابها.
حين ضربت التفجيرات لندن قبل خمس سنوات، وقتل بسببها 59 شخصا وجرح 700، فإن البلد صدم حقا، لكنه لم يصب باللوثة التي نشهد أصداءها في مصر الآن، وإنما أعطى الحدث حجمه وتم التعامل مع الجريمة برصانة وهدوء، واعتقل في الحادث رغم فداحته ثمانية أشخاص لا غير، أخذ القانون مجراه في التعامل معهم.
إن الترهيب لم يعد مقصورا على الحكومات والأجهزة الأمنية فقط، ولكن هناك أيضا إرهاب المثقفين الذي تفرضه عليهم تحيزاتهم على نحو يضيق بالتجرد والاستقامة الفكرية.
وهناك كذلك إرهاب الجماهير التي شحنت بالتحيزات وفتنت بالتصنيفات، ووفرت لها ثورة الاتصال إمكانات الجهر بالتلاسن ومحاكمة كل صاحب رأي مخالف.
من المفارقات أن المثقفين الذين يثير غضبهم النقد النزيه هم أنفسهم الذين لا يكفون عن إعطائنا دروسا في ضرورة احترام الرأي الآخر، ودروسا أخرى في الغيرة على البلد وضرورة الارتفاع بمصالح الوطن فوق حسابات الفئة أو الطائفة.
........................
January 14, 2011
دعوة لتأييد الطوارئ
دعوة لتأييد الطوارئ – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/01/blog-post_15.html
حين يصرح نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بأنه لولا الطوارئ لأصبحت مصر عراقا ثانيا. فإنه يصدمنا ثلاث مرات على الأقل.
مرة بسبب مضمون الرسالة فى تصريحه،
ومرة بسبب موقع المرسل
ومرة ثالثة بسبب كونه رجل قانون بالأساس.
لقد نشر تصريح المستشار مقبل شاكر فى الثالث من يناير الحالى. وتصورت أن الرجل أدرك أنه ليس من اللائق أن يصدر عنه هذا الكلام. وتوقعت أن يصححه أو يكذبه خلال الأيام التالية، لكن ذلك لم يحدث. وهو ما يعنى أنه يعبر عن قناعته الحقيقية، وأن ما أفصح عنه لقى رضا واستحسانا ممن يعنيهم الأمر
. ذلك أنه وفر على وزير الداخلية أو رئيس مباحث أمن الدولة ما يمكن أن يقوله فى هذه المناسبة، وأعفاهم من أى تبرير للمطالبة باستمرار قانون الطوارئ، ليس لسنة أو سنتين، وإنما لتأبيده أيضا.
ذلك أنه بشهادة الرجل الثانى فى مجلس حقوق الإنسان لا يمكن لمصر أن تستشعر الأمان والاستقرار إلا إذا حكمت بقانون الطوارئ وعصاه الغليظة.
وهى كارثة أن يكون ذلك رأى الرجل الثانى فى مجلس حقوق الإنسان، وتتضاعف الكارثة إذا علمنا أنه من رجال القانون وأنه كان يوما ما رئيسا لمحكمة النقض.
ذلك أن مجلس حقوق الإنسان يفترض أن يحفظ للناس كرامتهم ويدافع عن إنسانيتهم، وقانون الطوارئ هو الباب الرسمى الذى يبرر إهدار الاثنين. وليست فى ذلك أية مبالغة. ذلك أن القانون ينص فى مادته الثالثة مثلا على أن لرئيس الجمهورية فى ظل الطوارئ أن يأمر كتابة أو شفاهة باعتقال أى مواطن وله أن يكلف أى شخص بأى عمل دون التقيد بأحكام القانون!
من ناحية ثانية فإن أى طالب فى كلية الحقوق يعلم جيدا أن تطبيق قانون الطوارئ يعنى فى واقع الأمر تعطيل القوانين المتعلقة بالحريات العامة وصيانة حقوق الناس وكراماتهم. بما يعنى أنه دعوة لسيادة اللاقانون، وتمكين الأجهزة الأمنية من إطلاق يدها فى الاعتقال والتنصت والرقابة والتفتيش. ومن ثم التنكيل بكل ما لا ترضى عنه السلطة. بل بكل ما لا يرضى عنه ضابط مباحث صغير فى أصغر قرية أو نجع.
وإذا كان ذلك من المعلوم بالضرورة لطلاب كلية الحقوق، فما بالك به إذا كان المتكلم رئيسا لمحكمة النقض يوما ما.
ليت ما قاله الرجل صحيح. لأن تجربتنا مع قانون الطوارئ أنه لم يحل يوما دون التصدى للإرهاب أو إجهاض العمليات الإرهابية.
ومبلغ علمنا أنه جعل الأجهزة الأمنية صاحبة الكلمة العليا فى البلد، حيث بات بمقدورها أن تبطش بمن تشاء وأن تسوق إلى المعتقلات من تشاء. وتلفق التهم للأبرياء.
الذى لا يقل سوءا عن ذلك أن استمرار تطبيق القانون لأكثر من ثلاثين عاما أفسد أجيالا من ضباط الشرطة. الذين تصوروا أن القانون الاستثنائى هو الأصل. وأن القوانين العادية لا قيمة لها ولا وزن. حتى أصبح أغلبهم يتعاملون مع المجتمع بمنتهى الازدراء والاستهتار والقسوة.
إن ما قاله نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان يجرح شرعيته كرجل يفترض أنه أحد الذين يقومون على حراسة المجتمع، من حيث إن كلامه يعبر عن انحياز صريح للعصا الغليظة التى تستخدم لقمع المجتمع.
بل لعلى لا أبالغ إذا قلت إن كلامه يعد إهانة للمجتمع وازدراء به.لأن مضمون رسالته يقول إن هذا بلد لا تصلح له القوانين العادية التى تطبق فى أنحاء الكرة الأرضية، ولا يدار إلا بالسوط والعصا.
من ناحية أخرى، فإن الرسالة التى بعث بها صاحبنا فى كلامه المهين تسلط الضوء على حقيقة المستهدف من تشكيل مجلس حكومى لحقوق الإنسان.
ذلك أن اللافتة لا علاقة لها فى حقيقة الأمر بالوظيفة. وأغلب الظن أن الدافع الأساسى لإنشائه كان محاولة تقليد المجتمعات الديمقراطية وحتى لا تنفرد بالساحة المنظمات الأهلية والدولية الناشطة فى ذلك الميدان. ولكى يتولى المجلس التستر على انتهاكات حقوق الإنسان وتجميل ممارسات وزارة الداخلية
لا أظن أن أحدا فى مصر علق أملا يذكر على مجلس لحقوق الإنسان تشكله السلطة لكى يراقب أفعالها. لكنى فى الوقت ذاته لا أشك فى أن أحدا توقع يوما ما أن يدعو مسئول المجلس إلى تأييد قانون الطوارئ،
وإن كان يذكر للرجل أنه كان صريحا ولم يخف شيئا من مشاعره الحقيقية كممثل للسلطة لا علاقة له بحراسة المجتمع أو الدفاع عن كرامته.
وهى الخلاصة التى تنبهنا إلى أن أمثال تلك الهياكل الديمقراطية لا تؤدى دورها الحقيقى إلا فى مجتمعات ديمقراطية.
وأن إقامة تلك الهياكل فى ظل تغييب الديمقراطية بمثابة قلب للآية، بمقتضاه توضع العربة أمام الحصان، فى مشهد هزلى يبعث على الرثاء أكثر مما يبعث على السخرية والضحك.
......................
January 12, 2011
هذا المحتل الوطني!
صحيفة الشرق القطريه الخميس 9 صفر 1432 – 13 يناير 2011
هذا المحتل الوطني! – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/01/blog-post_13.html
الوضع في تونس قارب مرحلة الخطر. فمظاهرات الغاضبين دخلت أسبوعها الثالث والحريق يزداد اشتعالا في أنحاء البلاد، والسلطة اضطرت لاستخدام الجيش لأول مرة بعد فشل الشرطة، في محاولة بائسة لاحتواء الغضب وقمع المتظاهرين
ــ ثم إن ميليشيات النظام وقناصته وجهوا نيران أسلحتهم صوب المتظاهرين، الذين قتلوا 53 منهم يوم الأحد الماضي 9/1.
وحسب رواية شهود عيان فإن قناصة الميليشيات اعتلوا المباني السكنية لاصطياد قادة المظاهرات في بعض المدن.
إلى جانب ذلك فالأنباء تتحدث عن حملة اعتقالات واسعة بين النقابيين والمواطنين المتظاهرين. في حين تروج المواقع الإلكترونية لحملة طالت الرئيس زين العابدين بن على وزوجته وأفراد عائلتها. وتنسب إليهم قائمة طويلة من الاتهامات المتعلقة باستغلال النفوذ ونهب موارد الدولة.
وتدلل تلك المواقع على أن أحد أفراد أسرة الزوجة كان يعمل جزارا يوما ما، وأصبح الآن من أثرى أثرياء تونس، ويملك أسطولا من الطائرات. إلى غير ذلك من المعلومات التي يصعب التثبت من دقتها، لكنها أصبحت تعني شيئا واحدا هو أن الجماهير التونسية كسرت حاجز الخوف، ولم تعد تتردد في الجهر بصيحات الاحتجاج ونداءات التنديد بممارسات السلطة التي اتسمت بجرأة غير معهودة بين الشباب التونسي، الذي ظل طوال السنوات التي خلت يختزن المرارة والحزن توقيا لعصا النظام الغليظة ويده الباطشة.
لقد انفجر بركان الغضب في منتصف شهر ديسمبر الماضي في سيدي بوزيد، بعدما أحرق شاب نفسه احتجاجا على مصادرة عربة خضار يملكها، الأمر الذي أطلق غضب الجموع التي هدها الفقر.
وكان الظن أن الانتفاضة لن تستمر لأكثر من يومين أو ثلاثة، قياسا على المرات السابقة، التي كانت قوات الأمن المدربة تسارع فيها إلى سحق الغضب واحتوائه. لكن المفاجأة أن شرارة الغضب انتقلت من ولاية إلى أخرى.
وأن جذوتها ظلت متقدة للأسبوع الثالث على التوالي. خصوصا في ولايات الوسط التي عانت من وطأة الفقر وشدة البطالة. وكانت مدينتا تالة والقصرين أحدث مسرحين للتظاهرات والاشتباكات مع الشرطة. وقد وصف شهود العيان تلك الاشتباكات بأنها «عنيفة»،
وذكروا أن المتظاهرين أحرقوا مقر إدارة التجهيز الرسمية، وأن الشرطة استعملت خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع، قبل أن تطلق النار بعد ذلك على المحتجين. وأضاف هؤلاء أنهم رأوا عربات الجيش تدخل المدينة في مسعى للسيطرة عليها وإعادة الهدوء إلى أرجائها.
ما حدث في تالة تكرر في مدينة الرقاب، التي سارعت فيها الشرطة إلى إطلاق النار على المحتجين فقتلت منهم ثلاثة. وقد تصاعدت الاشتباكات حين ردد المتظاهرون هتافات مناهضة للحكومة ومنددة بالرئيس بن على.
كما هي العادة فإن البيانات الرسمية، التي اعترفت بالصراعات العنيفة، ذكرت أن الشرطة لم تلجأ إلى استخدام السلاح إلا بعد أن قامت بإطلاق أعيرة تحذيرية «في إطار الدفاع المشروع عن النفس»، وبعد أن تعرضت لهجمات من جانب أفراد استخدموا العبوات الحارقة والعصي والحجارة.
كما ادعت تلك البيانات أن مجموعات من المتظاهرين أقدمت على تخريب ونهب وحرق مؤسسات مصرفية ومركز للأمن ومحطة وقود. بما يعني أن الشرطة «البريئة» لم تطلق النار إلا من قبيل الدفاع أمام «العدوان»، الذي تعرضت له من قبل الجماهير الغاضبة.
المعارضة في الخارج اتهمت الحكومة باتباع سياسة القمع وحماية الفساد ودعت الجيش والشرطة إلى عدم إطلاق النار على «إخوانهم» المواطنين المتظاهرين،
في حين أن المعارضة في الداخل طالبت الرئيس بن على بوقف إطلاق النار حفاظا على أرواح المواطنين وأمنهم، واحتراما لحقهم في التظاهر السلمي.
أما الرئيس بن على فإنه حذر من أن أعمال الشغب تضر بصورة البلاد وسمعتها لدى السياح والمستثمرين، وتوعد من وصفهم بأقلية المتطرفين الذين خرجوا في مختلف المدن بالعقاب الحازم.
حين تطلق السلطة النار على جماهيرها يكون النظام قد أدرك أنه يخوض معركته الأخيرة.
وحين تتواصل مظاهرات الغضب لأكثر من ثلاثة أسابيع فمعناه أن المجتمع فاض به الكيل وأنه لم يعد يتوقع خيرا من النظام القائم ويتوق إلى بديل عنه.
وحين تنتقل مظاهر الغضب من مدينة إلى أخرى فمعناه أن البلد كله يواجه أزمة وليس فئة بذاتها.
ما الذي يمكن أن يحدث؟
في النظم المستبدة التي يتم فيها احتكار السلطة وتظل شرعية النظام مستندة إلى قبضة الأمن وليس إلى رضا الناس، فإن المستقبل يبدو معتما وتظل البدائل في علم الغيب،
ومن ثم تصبح كل الخيارات مطروحة باستثناء خيار واحد هو: الانتقال السلمي للسلطة.
يسري ذلك على تونس كما يسرى على غيرها من الدول، التي تعاني قبضة المحتل الوطني، الذي تبين أنه أسوأ من المحتل الأجنبي.
وليس هذا كلامي، لكنه رأى سمعته على لسان عجوز تونسي من سكان سيدي بوزيد كان يترحم عبر إحدى الإذاعات على زمن الاستعمار الفرنسي.
...............................
January 11, 2011
هل نغلق المساجد؟
صحيفة الشرق القطريه الأربعاء 8 صفر 1432 – 12 يناير 2011
هل نغلق المساجد؟ - فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/01/blog-post_12.html
ما الذي تستطيع قصور الثقافة أن تفعله أمام 120 ألف مسجد وزاوية في مصر؟
السؤال طرحه السيد فاروق حسنى وزير الثقافة أثناء مناقشة أجرتها معه مجلة روزاليوسف في عددها الأخير (8/1).
كان الحوار قد تطرق إلى ملف التطرف المثار هذه الأيام. وكان السؤال الذي وجهه رئيس تحرير المجلة للوزير هو:
لماذا انتصرت عليك مؤسسة التطرف؟
وهو ما رد عليه الوزير بقوله:
قل لي من الأقوى في المجتمع: الخطيب الواقف على المنبر أم المفكر؟
ثم ألحق كلامه بالسؤال عن تناقض الأدوار بين قصور الثقافة والمساجد والزوايا.
لم يكن السؤال استفهاميا بقدر ما أنه احتجاجي واستنكاري، أراد به الوزير أن يعبر عن التضاد بين الدور «التنويري» الذي تقوم به قصور الثقافة، والدور «الظلامي» الذي تؤديه المساجد والزوايا.
والجملة الأخيرة من عندي، لأن الوزير لم يستخدم هذه الكلمات، ولكن سياق حديثه أشار إليها ضمنا. فضلا عن أن ثمة خطابا عبر عنه نفر من المثقفين يعتبر أن التدين هو المشكلة وهو التربة التي تستنبت التطرف.
ولأحد كبار موظفي وزارته كتابات عدة ادعى فيها أن جريمة التدين زادت عن حدها في مصر.
وعبر آخرون عن ذات الفكرة حين زعموا أن «السلفية» زحفت إلى العقل المصري واحتلت مساحة كبيرة منه.
ويبدو أن تلك الأصوات أحدثت مفعولها في الأوساط الرسمية، حتى تردد أن وزارة الإعلام اتجهت إلى تخفيف جرعة التدين في برامجها. في أعقاب فاجعة التفجير التي حدثت في الإسكندرية.
وإذا صح ذلك فإنه يندرج ضمن الآثار الخطيرة للفاجعة. التي وضعت الإسلام وتعاليمه والمتدينين على إطلاقهم في قفص الاتهام، وبات السؤال المطروح هو كيف يمكن التصدي لكل هؤلاء. وكما أن أهل الأمن والسياسة وجدوها فرصة للدفاع عن استمرار العمل بقانون الطوارئ. فإن فئات من الكارهين الذين يبغضون الإسلام وأهله انتهزوا الفرصة ذاتها لإضعاف الإسلام وإيغار الصدور ضده.
رغم أن الوزير لم يستخدم وصف الظلامية في وصف خطاب المساجد والزوايا إلا أن كلامه واضح في أن ذلك الخطاب يتناقض مع الخطاب الذي تتبناه قصور الثقافة. وأعطى انطباعا بأن ثمة معركة بين الطرفين. وهو منطق يثير الدهشة من ناحيتين.
فالوزير أطلق اتهامه وتحدث عن جميع المساجد والزوايا في مصر دون أن يستثنى شيئا منها. وهذا التعميم يعنى أن وجود تلك المساجد والزوايا هو المشكلة، الأمر الذي يستدعى السؤال التالي:
هل يكون الحل بإغلاقها لكي تتاح الفرصة كاملة لقصور الثقافة لكي تبث التنوير على راحتها؟
من ناحية ثانية فإن المنطق والعقل يفترضان أن تتكامل الأدوار التي تقوم بها قصور الثقافة والمساجد، فلا تتنافى أو تتعارك. خصوصا أننا نتكلم عن حكومة واحدة تضم بين أعضائها وزيرا للثقافة مسؤولا عن قصور الثقافة ووزيرا للأوقاف قائما على أمر المساجد، والتكامل المنشود يعد من أبسط مقتضيات التنسيق بين الوزارتين.
أزعم أن هيمنة الخطاب السلفي على العقل المصري فرية خبيثة، فضلا عن أنها فضيحة ثقافية ــ لماذا؟ ــ
هي فرية لأنها غير صحيحة. إذ رغم أن الخطاب السلفي اخترق الساحة المصرية خلال ربع القرن الأخير بسبب الفراغ الذي نشأ فيها والذي صنعته السلطة بأيديها، إلا أن ذلك الاختراق لا يمكن أن يوصف بأنه هيمنة.
وإذا كانت هناك بعض القنوات الفضائية تبث خطابا سلفيا، ففي مقابلها عدد هائل من القنوات لا علاقة لها بالسلفية. وأغلبها معاد لها. وهى خبيثة لأن الذين يتذرعون بهيمنة الخطاب السلفي يتخذون منه قناعا لملاحقة وإعلان الحرب على مجمل الخطاب الديني. تماما كما أن الأنظمة الاستبدادية اتخذت من الحرب ضد الإرهاب ذريعة لقمع كل معارضيها السياسيين وتصفيتهم.
أما كونها فضيحة ثقافية فمرجع ذلك أنه لا يجوز ولا يليق أن تصور مصر بلد الأزهر وقلعة الاعتدال الديني في العالم الإسلامي بحسبانها بلدا انهارت وسطيته واستسلم للفكر السلفي، الذي يتراجع حاليا في السعودية، حاضنته الطبيعية والتاريخية.
لي ملاحظتان أخيرتان،
الأولى تتعلق بانصراف الناس عن قصور الثقافة وإقبالهم على خطاب المساجد والزوايا. إذ لا أعرف لماذا يعد ذلك انتصارا للفكر المتطرف، ولا يعد إعراضا عن خطاب قصور الثقافة وإشهارا لتفاهته وإفلاسه.
الملاحظة الثانية أن الوزير وهو يتحدث ظل نظره مصوبا نحو المسلمين المتطرفين ودعاة التكفير، فلا هو رأى مسلمين معتدلين، ولا هو لاحظ أن ثمة متطرفين بين غير المسلمين. وهى مشكلة أن تكون تلك رؤية وزير في الحكومة، ومشكلة أكبر أن يكون الرجل وزيرا للثقافة.
.......................
January 10, 2011
إسرائيليون يروون قصة الانفصال – المقال الأسبوعي
صحيفة الشرق القطريه الثلاثاء 7 صفر 1432 – 11 يناير 2011<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
إسرائيليون يروون قصة الانفصال – فهمي هويدي – المقال الأسبوعي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/01/blog-post_11.html
طالما أننا عجزنا عن الدفاع عن وحدة السودان، فربما يفيدنا بأن نفهم ما جرى، ربما نبهنا ذلك إلى أن انفصال الجنوب ليس نهاية المطاف، ولكنه حلقة في مسلسل تفكيك العالم العربي وتطويق مصر.
ــ1ــ
منذ وقت مبكر للغاية أدرك قادة الحركة الصهيونية أن الأقليات في العالم العربي تمثل حليفا طبيعيا لإسرائيل، من ثَمَّ خططت لمد الجسور معها، فتواصل رجالها مع الأكراد في العراق وسكان جنوب السودان، والموارنة في لبنان، والأكراد في سوريا والعراق، والأقباط في مصر،
واعتمدت في مخططها على مبدأ فرق تسد، حيث اعتبرت أن تلك هي الوسيلة الأنجع لتفتيت الوطن العربي من خلال خلق كيانات انفصالية في داخلها،
واستهدفت بذلك إعادة توزيع القوى في المنطقة، على نحو يجعل منها مجموعة من الدول المهمشة المفتقدة لوحدتها وسيادتها، مما يسهل على إسرائيل، وبالتعاون مع دول الجوار غير العربية، مهمة السيطرة عليها الواحدة تلو الأخرى فيما بعد،
يؤكد ذلك أن جميع حركات التمرد التي فجرتها الجماعات الإثنية والطائفية في العالم العربي، استمدت الدعم والتأييد والإسناد من الأجهزة الإسرائيلية التي أنيطت بها مسؤولية تبني تلك الحركات الانفصالية، كما حدث مع الأكراد في العراق وحركة التمرد في جنوب السودان.
هذا الموقف يساعد على فهم واستيعاب الإستراتيجية الإسرائيلية إزاء المنطقة العربية، التي تستهدف تشجيع وحث الأقليات على التعبير عن ذاتها بحيث تمكن في نهاية المطاف من انتزاع حقها في تقرير المصير والاستقلال عن الوطن الأم،
يؤيد هذه الفكرة ويغذيها أن المنطقة العربية، وعلى خلاف ما يدعي العرب، ليست وحدة ثقافية وحضارية واحدة، وإنما هي خليط متنوع من الثقافات والتعدد اللغوي والديني والإثني، وقد اعتادت إسرائيل تصوير المنطقة على أنها فسيفساء تضم بين ظهرانيها شبكة معقدة من أشكال التعدد اللغوي والديني والقومي، ما بين عرب وفرس وأتراك وأرمن وإسرائيليين وأكراد وبهائيين، ودروز ويهود وبروتستانت وعلويين وصابئة وشيعة وسنة وموارنة وشركسي وتركمان وآشوريين.. إلخ.
إن خريطة المنطقة في النظر الإسرائيلي تعرف بحسبانها بقعة من الأرض تضم مجموعة أقليات لا يوجد تاريخ يجمعها، من ثَمَّ يصبح التاريخ الحقيقي هو تاريخ كل أقلية على حدة،
والغاية من ذلك تحقيق هدفين أساسيين هما:
أولا: رفض مفهوم القومية العربية والدعوة إلى الوحدة العربية، ذلك أن القومية العربية في التصور الإسرائيلي فكرة يحيطها الغموض، إن لم تكن ذات موضوع الإطلاق،
وهم يعتبرون أن الوحدة العربية خرافة، فالعرب يتحدثون عن أمة واحدة، لكنهم يتصرفون كدول متنافرة، صحيح أن ما يجمع بينهم هو اللغة والدين، وهما يجمعان بعض الشعوب الناطقة بالإنجليزية أو الإسبانية دون أن يخلق منها أمة واحدة.
ثانيا: تبرير شرعية الوجود الإسرائيلي الصهيوني في المنطقة، إذ هي وفقا لذلك التوجه تصبح خليطا من القوميات والشعوب واللغات، وتصور قيام وحدة بينها هو ضرب من الوهم والمحال،
النتيجة المنطقية لذلك هي أن تكون لكل قومية دولتها الخاصة بها، ومن هذه الزاوية تكتسب إسرائيل شرعيتها، حيث تصبح إحدى الدول القومية في المنطقة.
ــ2ــ
لست صاحب الفقرات السابقة، ولكنني نقلتها نصا من كتاب «إسرائيل وحركة تحرير جنوب السودان» الذي صدر عام 2003 عن مركز ديان لأبحاث الشرق الأوسط وإفريقيا، ومؤلفه هو عميد الموساد المتقاعد موشى فرجي،
وقد سبق أن استشهدت به وأشرت إليه أكثر من مرة من قبل، لكنني اعتبرت أن استعادة الشهادة في الوقت الراهن لها مذاقها الخاص، لأننا بصدد لحظة حصاد ثمار الزرع الذي غرسته إسرائيل والقوى الدولية الواقفة معها منذ خمسينيات القرن الماضي.
استأذن هنا في «فاصل قصير» نترك فيه مؤقتا نص العميد فرجي، لنقرأ نصا آخر ورد في شهادة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الأسبق آفي إيختر، تطرق فيه إلى السودان في محاضرته التي ألقاها في عام 2008 أمام معهد أبحاث الأمن القومي الصهيوني.
قال صاحبنا عن السودان ما يلي،
كانت هناك تقديرات إسرائيلية منذ استقلال السودان في منتصف الخمسينيات إنه لا يجب أن يسمح لهذا البلد رغم بعده عنا، بأن يصبح قوة مضافة إلى قوة العالم العربي، لأن موارده إذا ما استمرت في ظل أوضاع مستقرة، ستجعل منه قوة يحسب لها ألف حساب.
في ضوء هذه التقديرات كان على إسرائيل بمختلف أجهزتها وأذرعها أن تتجه إلى الساحة السودانية، لكي تفاقم من أزماتها وتسهم في إنتاج أزمات جديدة، بحيث يكون حاصل تلك الأزمات معضلة يصعب معالجتها فيما بعد.
لأن السودان يشكل عمقا إستراتيجيا بمصر، وهو عنصر تجلى بعد حرب عام 1967، حين تحول السودان ومعه ليبيا إلى قواعد تدريب وإيواء سلاح الجو المصري والقوات البرية، علما بأن السودان أرسل قوات إلى منطقة القناة أثناء حرب الاستنزاف التي شنتها مصر بين عامي 1968 و1970.
لهذين السببين ــ أضاف ديختر ــ كان لابد أن تعمل إسرائيل على إضعاف السودان وانتزاع المبادرة منه لعدم تمكينه من بناء دولة قوية موحدة، وهذا المنظور الإستراتيجي يشكل إحدى ضرورات دعم وتنظيم الأمن القومي الإسرائيلي،
(لاحظ أن المحاضرة ألقيت في عام 2008 بعد نحو ثلاثين عاما من توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979).
حين سئل الرجل عن مستقبل جنوب السودان كان نص رده كالتالي:
هناك قوى دولية تتزعمها الولايات المتحدة مصرة على التدخل المكثف في السودان لكي يستقل الجنوب، وكذلك إقليم دارفور، على غرار استقلال كوسوفو، حيث لا يختلف الوضع في جنوب السودان ودارفور عن كوسوفو، في حق الإقليمين في التطلع إلى الاستقلال واكتساب حق تقرير المصير بعد أن قاتل مواطنوهم لأجل ذلك.
ــ3ــ
دعم إسرائيل للمتمردين في جنوب السودان، مر بخمس مراحل سجلها العقيد فرجي في كتابه على النحو التالي:
* المرحلة الأولى: بدأت في الخمسينيات، مباشرة بعد تأسيس دولة إسرائيل، وخلال تلك الفترة التي استمرت نحو عقد من الزمن اهتمت إسرائيل بتقديم المساعدات الإنسانية (الأدوية والمواد الغذائية والأطباء)،
كما حرصت على تقديم الخدمات للاجئين الذين كانوا يفرون إلى إثيوبيا، وفي هذه المرحلة بدأت أولى المحاولات لاستثمار التباين القبلي في جنوب السودان ذاته لتعميق حدة وهوَّة الصراع، ومن ثم تشجيع الجنوب على الانفصال،
كما قام ضباط الاستخبارات الإسرائيلية الذين تمركزوا في أوغندا بفتح قنوات الاتصال مع زعماء قبائل الجنوب لدراسة الخريطة السكانية للمنطقة.
* المرحلة الثانية: (بداية الستينيات): اهتمت إسرائيل بتدريب عناصر من الجيش الشعبي على فنون القتال، في مراكز خاصة أقيمت في إثيوبيا،
وفي هذه المرحلة تبلورت لدى الحكومة الإسرائيلية قناعة بأن توريط السودان في الحروب الداخلية كفيل بإشغاله عن أي مساندة يمكن أن تقدم إلى مصر في صراعها مع إسرائيل، وكانت منظمات التبشير تقوم بنشاط ملحوظ في الجنوب، الأمر الذي شجع إسرائيل على إيفاد عناصرها الاستخبارية إلى الجنوب تحت شعار تقديم العون الإنساني، في حين أن الهدف الأساسي كان استيعاب عناصر مؤثرة من السكان لتدريبهم لإدامة التوتر في المنطقة،
وفي هذه المرحلة أيضا عمدت إسرائيل إلى توسيع نطاق دعمها للمتمردين، عن طريق تقديم الأسلحة لهم عبر الأراضي الأوغندية، وكانت أولى تلك الصفقات في عام 1962، ومعظمها كانت من الأسلحة الروسية الخفيفة التي غنمتها إسرائيل في عدوانها على مصر عام 1956،
واستمرت عمليات تدريب المقاتلين الجنوبيين في أوغندا وإثيوبيا وكينيا، ثم الدفع بهم للاشتراك في القتال داخل الحدود السودانية.
* المرحلة الثالثة: التي امتدت من منتصف الستينيات وحتى السبعينيات، وقد استمر خلالها تدفق الأسلحة على الجنوبيين من خلال تاجر أسلحة إسرائيلي وسيط اسمه جابي شفين كان يعمل لصالح الاستخبارات، وأرسلت إلى الجيش الشعبي شحنات من الأسلحة الروسية التي غنمتها إسرائيل في حرب 1967، وقامت طائرات الشحن الإسرائيلية بإسقاط تلك الأسلحة والمعدات على ساحة المعسكر الرئيسي للمتمردين في أورنج ــ كي ــ بول،
كما قامت إسرائيل بإنشاء مدرسة لضباط المشاة في (ونجي ــ كابل) لتخريج الكوادر اللازمة لقيادة فصائل التمرد، وكانت عناصر إسرائيلية تشترك في المعارك لتقديم خبراتها للجنوبيين.
وفي هذه المرحلة أيضا تم استقدام مجموعات من الجيش الشعبي إلى إسرائيل لتلقي تدريبات عسكرية،
وفي بداية السبعينيات ــ فتحت بشكل رسمي نافذة أخرى لإيصال الدعم الإسرائيلي إلى جنوب السودان عبر أوغندا.
وحينما بدا أن حركة التمرد على وشك الانتهاء في عام 1969، بذلت إسرائيل جهدا هائلا لحث المتمردين على مواصلة قتالهم، واستخدمت في ذلك كل أساليب الكيد والدس التي استهدفت إقناع الجنوبيين بأنهم يخوضون صراعا قوميا مصيريا بين شمال عربي مسلم محتمل وجنوب زنجي أفريقي مسيحي ووثني، يعاني فيه أهل الجنوب من الحرمان والظلم.
* المرحلة الرابعة: الممتدة في أواخر السبعينيات وطوال عقد الثمانينيات، وفيها شهدت القارة الإفريقية عدة تقلبات لم توقف دعم إسرائيل للمتمردين، وقد ازداد الدعم بعدما أصبحت إثيوبيا ممرا منتظما لإيصال الأسلحة للجنوب،
وبرز جون فرنق في هذه المرحلة كزعيم ساندته إسرائيل واستقبلته في تل أبيب وزودته بالمال والسلاح وحرصت على تدريب رجاله على مختلف فنون القتال، وكان بينهم عشرة طيارين تدربوا على قيادة المقابلات الخفيفة.
* المرحلة الخامسة: بدأت في أواخر عام 1990 استمر الدعم الإسرائيلي واتسع نطاقه، وأصبحت الشحنات تصل إلى الجنوب عبر كينيا وإثيوبيا، وقد زودت إسرائيل الجنوبيين بالأسلحة الثقيلة المضادة للدبابات والمدافع المضادة للطائرات، ومع بداية العام 1993 كان التنسيق بين إسرائيل وبين الجيش الشعبي قد شمل مختلف المجالات، سواء فيما خص التمويل والتدريب والتسليح والمعلومات وإشراف الفنيين الإسرائيليين على العمليات العسكرية.
ــ4ــ
كما رأيت ــ وبشهادتهم ــ فإنهم لم يغمضوا أعينهم لحظة عن جنوب السودان منذ نصف قرن.
من الملاحظات الأخرى الجديرة بالانتباه أن حركة التمرد في الجنوب بدأت في عام 1955 أي قبل عام واحد من إعلان الاستقلال في عام 1956، بما يعني أن التمرد حين انطلق لم يكن له علاقة بفكرة تطبيق الشريعة التي دعت إليها حكومة الإنقاذ (البشير ــ الترابي) في سنة 1989.
من تلك الملاحظات أيضا أنه في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل تدعم الجنوبيين بالسلاح، فإن الدول الغربية كانت تواصل مساعيها الدبلوماسية لترتيب أمر انفصال الجنوب من خلال الاستفتاء،
فاتفاقية نيفاشا للسلام التي وقعت بين حكومة الخرطوم والمتمردين تمت برعاية أمريكية ــ نرويجية ــ بريطانية إضافة إلى منظمة إيقاد، وهذه الاتفاقية تم التوصل إليها عبر سلسلة من المفاوضات المتقطعة في أديس أبابا ونيروبي وأبوجا عاصمة نيجيريا، كما أن اتفاق ماشكوس الأول تم بناء على مبادرة قدمتها الولايات المتحدة.
منذ أكثر من نصف قرن وهم يمهدون للانفصال بالسلاح في جانب وبالضغوط والألاعيب الخبيثة في جانب آخر، ولو أن ربع هذا الجهد الدولي بذل لحل مشكلة فلسطين لأغلق ملف القضية واسترد الفلسطينيون حقوقهم منذ زمن بعيد، لكن تقرير المصير والاستقلال حلال على الجنوبيين حرام على الفلسطينيين.
لقد خططوا لأجل الانفصال وتحقق لهم ما أرادوا،
أما العرب فقد وقفوا متفرجين على ما يجري وذاهلين عن مراميه،
وكانت النتيجة أن الذي زرع حصد الاستقلال،
ومن وقف متفرجا ذاهلا حصد الخيبة، التي أرجو ألا تكون لخيبات أخرى في العام الجديد.
.........................
فهمي هويدي's Blog
- فهمي هويدي's profile
- 1314 followers