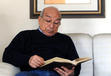فهمي هويدي's Blog, page 193
May 18, 2011
اختبار الجهاد الأكبر
اختبار الجهاد الأكبر - فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/05/blog-post_19.html
هذا خبر استثنائي يستحق التنويه والحفاوة:
أطلق ائتلاف شباب ثورة 25 يناير بالإسكندرية مبادرة لدعم القطاع الزراعي بمحافظتي الإسكندرية ومطروح، وتنفيذ مشروعات شباب الخريجين الذين تم تهميشهم في ظل النظام السابق.
وقال طارق الدسوقي المنسق العام لائتلاف شباب الثورة بالإسكندرية انه تم تنظيم ملتقى للحوار مع المسئولين والزراعيين استهدف تطوير القطاع الزراعي والنهوض به لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسية.
الخبر نشرته صحيفة «الوفد» يوم 10/5 الحالي، ولم أجد له أثرا في بقية الصحف التي صدرت يومذاك، ليس فقط لأن الصفحات الأولى، ومصر كلها، كانت مشغولة بقصة عبير وفتنة إمبابة، ولكن أيضا لأن الحدث وقع خارج القاهرة، وبالتالي خارج بؤرة الضوء ومركز الاهتمام. وقد اعتبرته خبرا استثنائيا لأن موضوعه هو المجتمع وليس السلطة.
ولعلك لاحظت أن تغير المجتمع والانشغال بهمومه ومعاناته لا يحتل أولوية ليس من جانب الأحزاب السياسية فحسب، وإنما أيضا من جانب أغلب التجمعات التي ظهرت بعد ثورة 25 يناير.
ورغم أن روحا جديدة دبت في أوصال مصر وأرجائها بعد الثورة للنهوض بالمجتمع وتغييره، فإننا وجدنا النخب والتجمعات الجديدة غلب عليها الاهتمام بتغيير السلطة. إذ شغل الجميع بتأسيس الأحزاب والانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومخاطبة الرأي العام من خلال شاشات التليفزيون، وليس عبر الوجود في الشارع.
صحيح أن خبر صحيفة الوفد لم يذكر شيئا عن تفاصيل مبادرة ائتلاف ثورة 25 يناير بالإسكندرية، بما يسمح لنا أن نحكم على مدى جديتها، لكن أكثر ما همني فيما نشر هو الفكرة والتوجه.
وكنت قد عبرت في مناسبة سابقة عن خشيتي من افتتان شباب الثورة بالظهور في التليفزيون، بما قد يحولهم من مناضلين اكتسبوا شرعيتهم من الميدان ومن التعبير عن ضمير المجتمع وتطلعاته، إلى نجوم يتعلقون بالشهرة ويكتسبون شرعيتهم من الوجود المستمر على شاشات التليفزيون.
وقلت صراحة إن من شأن ذلك إغواء وإفساد أولئك الشبان بمضي الوقت. وكانت لدي قرائن عدة في ذلك لا مجال لذكرها الآن، لكني لا أذيع سرا إذا قلت إن تلك الغوايات أفسدت العلاقة بين بعض أولئك الشبان، الذين اقتنعوا بأنهم أصحاب الثورة وصناعها، وأنهم الممثل الشرعي الوحيد لها.
وحين يكون هناك أكثر من ممثل شرعي «وحيد»، فإن ذلك يفتح الأبواب لبروز حساسيات ومشكلات لا حصر لها، لكن ما يطمئننا في الوقت الراهن أن الكثرة منهم لم تفتن بعد، وأنهم على قدر الوعي والمسئولية اللذين كانوا عليهما منذ بداية الثورة.
لقد سمعت من بعض القريبين من دوائر أولئك الشباب أن الناشطين منهم خارج القاهرة، في الدلتا والصعيد، أكثر جدية وأكثر اقترابا وتفاعلا مع المجتمع، وإن أولوياتهم مختلفة عن أولويات نظرائهم المقيمين في القاهرة. ويبدو أن هذا الانطباع صحيح، ومن قرائنه ذلك الخبر الذي نشرته صحيفة الوفد.
هذا الانشداد للعمل السياسي المباشر ولأضواء القاهرة ليس مقصورا على شباب الثورة وحدهم، ولكننا لاحظناه أيضا في أنشطة الجماعات الإسلامية التي ظهرت على السطح بعد الثورة، ذلك أن بعضها اتجه إلى تأسيس الأحزاب والدخول في التحالفات السياسية، في حين حرص البعض الآخر على الانخراط فيما يحدث الضجيج والجلبة دون الفعل الاجتماعي والبناء.
وما المسيرات التي ينظمونها هذه الأيام المتعلقة بالسيدات اللاتي قيل إنهن تحولن من المسيحية إلى الإسلام إلا نموذج للجهد الذي يبذل لإحداث ضجيج لا جدوى منه ولا «طحن» من ورائه.
إن ثمة مساحات واسعة للعمل الاجتماعى العام لا تزال تبحث عن جهد الجماعات الأهلية للنهوض بها، في مجالات التعليم ومحو الأمية ونظافة الأحياء والقرى وفي تنشيط الحركة التعاونية والنهوض بالحرف اليدوية وترشيد الاستهلاك ورعاية الضعفاء.. إلى غير ذلك من المجالات التي تحتاج إلى جهد الناشطين المخلصين من أبناء الوطن،
وكنت قد أشرت في وقت سابق إلى مبادرة أهالي قرية ميت حواى بمحافظة الغربية إلى تشكيل جمعية للنهوض بقريتهم في المجالات المماثلة، فتلقيت اتصالا هاتفيا من مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة لمتابعة الموضوع، وأخبرنى أحد مسئولى المكتب بأن لديهم اعتمادات لإعانة وتمويل الأنشطة المحلية في مصر، لكنهم لا يجدون الجهات التي يمكن أن تستفيد منها وتستوعبها.
ما زلت عند رأيي في أن تغيير السطة هو الجهاد الأصغر، وأن تغيير المجتمع هو الجهاد الأكبر، الذي لا يمكن أن يتحقق الفوز فيه إلا إذا تم استدعاء واستنفار كل القوى الحية في المجتمع للإسهام فيه.
وذلك اختبار ينبغي ألا نسمح لأنفسنا بالرسوب فيه.
..................
May 17, 2011
الإصلاح ليس قضية لغوية
صحيفة السبيل الاردنيه الأربعاء 1 جمادي الاخره 1432 – 4 مايو 2011
الإصلاح ليس قضية لغوية – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/05/blog-post_18.html
حين يقرأ المرء أن الحكومة السورية شكلت لجنة لإعداد قانون جديد للانتخابات «يحاكي أفضل قوانين العالم» (الحياة اللندنية 12/5) فإنه لا يعرف بالضبط ما إذا كان عليه أن يضحك أم يبكي.
ذلك أننا بهذا الإعلان نصبح أمام وضع غاية في الغرابة. فسوريا منذ أربعين عاما على الأقل لم تعرف أي انتخابات عامة حرة. وبعد تلك المدة الطويلة نفاجأ بأن حكومتها بصدد إعداد قانون جديد من أفضل ما عرفته الكرة الأرضية. علما بأننا لا نعرف بالضبط مدلول العبارة، لأن الانتخابات إما أن تكون حرة أو مزورة ومغشوشة. وليست هناك انتخابات حرة فقط وأخرى حرة جدا وثالثة حرة جدا جدا.
والذي يحدِّث الناس عن انتخابات من الدرجة الممتازة يستغفلهم ويستخف بعقولهم. وهذا الاستخفاف يبلغ درجة العبث حين يطلق الوعد بعد تغييب للانتخابات والديمقراطية طوال أربعين عاما. لأنه لا يريد أن يقنعنا بأن النظام يريد أن ينتقل من زيرو ديمقراطية إلى أعلى درجات الخبرة البشرية في الممارسة الديمقراطية. في الوقت الذي يواصل فيه قتل المتظاهرين وحصار المدن كل يوم.
هذه المزايدة على التحول الديمقراطي تعني أن النظام السوري يحاول من خلال اللغة تحسين الصورة في الخارج، واستخدام أفعال التفضيل لدغدغة مشاعر الناس وامتصاص غضبهم في الداخل. وتعني أيضا أنه لا شيء سيتغير على الأرض، حيث ستظل الأوضاع كما هي. وليس ذلك من قبيل التخمين وإساءة الظن، لأن تعامل النظام السوري مع الاحتجاجات الداخلية التي تجاوزت أسبوعها الثامن لا تدع لنا فرصة لإحسان الظن بسياسته،
ليس ذلك فحسب، وإنما قدم لنا النظام الدليل الذي يقطع بإصراره على إبقاء الأوضاع التي سادت طوال الأربعين سنة الأخيرة دون تعديل يذكر. ذلك أنه حين تصاعدت الحركة الاحتجاجية فإن السلطة أعلنت عن اعتزامها إجراء عدة إصلاحات كان في مقدمتها إلغاء قانون الطوارئ المطبق منذ أربعين عاما. ورغم أن الإلغاء يتم بمجرد صدور قرار ولا يحتاج إلى وقت طويل، إلا أنه بعد مضي نحو عشرة أيام على الإعلان زفت الحكومة إلى الجماهير الخبر، وألغي القانون بالفعل.
ولم يتح لأحد أن يلتقط أنفاسه أو يحسن الظن بالخطوة التي تمت، لأنه في ذات يوم الإلغاء كانت الرصاصات تحصد أرواح السوريين المحتجين وكانت الدبابات والمدرعات تحاصر بعض المدن وتداهم مدنا أخرى. الأمر الذي يعني أن التعامل مع الطوارئ كان لغويا بدوره. فالقانون شطب حقا ولكن حالة الطوارئ ظلت مستمرة، وعقلية الطوارئ بقيت حاكمة، لذلك فلا غرابة في أن يتم التعامل مع الانتخابات بنفس الأسلوب. بحيث تظل التصريحات الرسمية في واد، في حين أن الواقع في واد آخر مختلف ومعاكس تماما.
أما ما يثير الدهشة حقا فهو تصور المسئولين في دمشق أن مثل تلك الوعود التي تلوح بالرغبة في الإصلاح يمكن أن تنطلى على الناس، رغم أنه لم يتح لهم أن يلمسوا على أرض الواقع ما يمكن أن يؤيد صدقيتها. صحيح أن السوريين تفاءلوا خيرا حين لوح الرئيس بشار الأسد بوعود الإصلاح منذ تولى المسئولية قبل أحد عشر عاما،
وصحيح أيضا أن البلد شهد تطورا نسبيا في الأوضاع الاقتصادية وقطاع الاتصالات والمعاملة في السجون. لكن دائرة الإصلاح السياسي ظلت مغلقة، أعني بذلك ما يتعلق بالحريات العامة وحق الناس في المشاركة في السلطة ومساءلة القائمين عليها. وحين يغلق ذلك الباب فإنه لا يعني فقط موت السياسة، لكنه يعني أيضا ــ وخبرتنا في مصر شاهدة ــ إطلاق يد أجهزة الأمن في إدارة البلد وقمع الناس. وذلك ما حدث في تعامل السلطة مع الاحتجاجات التي انطلقت من درعا قبل شهرين تقريبا.
إذ منذ لاحت بوادرها في الأفق ثم تناثرت شراراتها في بقية المحافظات، فإن وعود الإصلاح كانت تدبج وتطلق في الفضاء من دمشق. في حين كانت عمليات السحق والقمع الأمنيين تتواصل بشكل حثيث على الأرض في طول البلاد وعرضها.
أدري أن للنظام السوري خبرة عريضة في القضاء على الاحتجاجات وسحق أصحابها، مارسها في حماة عام 1982، لكنني أستغرب أن يتبع النظام ذات الأسلوب القمعي بعد نحو ثلاثين عاما. متجاهلا أن كل شيء تغير في داخل سوريا وفي العالم الخارجي.
ولا أخفي دهشة من أن تتصرف السلطة بذكاء مشهود في سياستها الخارجية، وبعقلية معاكسة تماما في السياسة الداخلية. بما يعني أنها معنية بشكل النظام بأكثر من عنايتها بشعبيته.
وحين يحدث ذلك في مرحلة من التاريخ العربي ارتفع فيها صوت الشعوب مدويا، فذلك يعني أن النظام السوري صار يعاند التاريخ بمثل ما عاند شعبه، الأمر الذي يجعله منتهى الصلاحية من الناحية السياسية، ومن ثم فاقدا للشرعية. وتداعيات هذا المصير لن تكون مقصورة على سوريا، وإنما ستكون لها أصداؤها القوية في الدول المحيطة بها، ولبنان أولها.
...................
May 16, 2011
العيش المشترك في خطر – المقال الأسبوعي
العيش المشترك في خطر – فهمي هويدي – المقال الأسبوعي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/05/blog-post_17.html
إذا كان التوافق على العيش المشترك شرطا لقيام المجتمع الواحد واستقراره، فأخشى أن يكون ذلك التوافق قد أصبح مشكوكا فيه بين النخب المصرية على الأقل.
(1)
أضع أكثر من خط تحت كلمة «النخب»، لأنني أزعم أن وشائج الناس العاديين لا تزال أمتن وأعمق من أن تمزقها المشاحنات والفرقعات التي صرنا نشهدها في مصر خلال الأشهر الأخيرة.
وسواء كان ذلك راجعا إلى البعد الحضاري والتاريخ المشترك، وإلى الجغرافيا التي حصرت المصريين في الوادي الضيق وكدستهم في الدلتا، فالشاهد أن تلاحم المصريين على اختلاف أطيافهم يظل حقيقة ثابتة ومستقرة، من ثَمَّ فإن ما يحدث على السطح من ضجيج أو اشتباك وتراشق أفسد الأجواء وشحن النفوس بالغضب وربما بالبغضاء حقا، لكنه لم يهتك أواصر القاع. على الأقل فذلك ما ألحظه في الدوائر التي أتواصل معها.
تلك حالة ليست فريدة في بابها، آية ذلك أنني قرأت للرحالة العربي ابن جبير (1145 ــ 1217م) ملاحظته التي سجلها إثر تجواله في عالم زمانه قوله إنه:
«من أعجب ما يحدث أن نيران الفتنة تشتعل بين الفئتين، مسلمين ونصارى، وربما يلتقي الجمعان منهم ويقع المصاف بينهم، ورفاق المسلمين والنصارى تختلف بينهم دون اعتراض، واختلاف القوافل من مصر إلى دمشق على بلاد الإفرنج غير منقطع... والاتفاق بينهم على الاعتدال. وأهل الحرب مشتغلون بحربهم، والناس في عافية، والدنيا لمن غلب».
إذا جاز لي أن أستخدم تعبير ابن جبير فإنني أزعم أن أهل مصر «في عافية» لا يزالون. لكن المشكلة تكمن في «أهل الحرب» الذين يتصدرون المواجهات ويعتلون المنابر والمنصات، ويطلون على المجتمع عبر شاشات التلفزيون. وذلك منطوق يحتاج إلى تحرير.
(2)
أهل الحرب في مصر الراهنة هم عناصر النخبة التي تشكلت في ظل أوضاع سياسية غير ديمقراطية فرضت على المجتمع ولم تكن من اختياره. وقد كان انحياز تلك الأوضاع واضحا للتيار العلماني بمختلف اتجاهاته (القومية والليبرالية واليسارية)، وكانت خصومتها ظاهرة للتيار الإسلامي بفصائله المتعددة.
هذا التحيز فتح أبواب التأثير والتمكين للمنتسبين للتيار الأول، بذات القدر الذي أحكم فيه حصار وحجب عناصر التيار الثاني. ولئن اختلت تلك المعادلة في بعض الأوقات (حين تعرض الشيوعيون للاعتقال في المرحلة الناصرية مثلا وحين اضطهد بعض المعارضين الليبراليين في عهدي السادات ومبارك) إلا أن ذلك الخلل ظل عارضا واستثنائيا، ولم يؤثر على جوهر القاعدة التي ظلت حاكمة، خصوصا للسنوات الثلاثين الأخيرة.
لم يكن التيار العلماني بشقيه الوطني والتغريبي غريبا على مصر، فقد كان له حضوره في الساحتين السياسية والثقافية منذ أواخر القرن التاسع عشر وطوال العهد الملكي، لكن تلك المرحلة تميزت بأمرين افتقدتهما مصر بعد الثورة.
الأول أن التيار العلماني وقتذاك لم يكن مخاصما للتيار الإسلامي، وإنما كان يعبر عن الاحترام لهوية مصر الإسلامية، وهو ما أثبتته بوضوح قاطع وثائق المؤتمر المصري الذي عقد في سنة 1911، وكان في مقدمة المشاركين فيه اثنان من رواد العلمانية في مصر هما عبدالعزيز فهمي «بك». وأحمد لطفي السيد «بك».
الأمر الثاني أن الساحة احتملت حضورا معلنا بين التيارين العلماني والإسلامي، وتعاونا في بعض القضايا المتعلقة بالمصالح العليا للمجتمع (المطالبة بالجلاء ومقاومة الاحتلال الإنجليزي مثلا).
هذا الوضع اختلف بعد ثورة يوليو 1952، إذ بسبب الصدام بين قادة الثورة وجماعة الإخوان المسلمين الرمز الأكبر للتيار الإسلامي فرض الحصار على ذلك التيار. وتضاعف ذلك الحصار بعد اغتيال السادات وظهور جماعات التطرف والإرهاب، خصوصا في بداية الثمانينيات من القرن الماضي.
وطوال تلك الفترة كانت الساحة المصرية حكرا على التيار العلماني بمعتدليه ومتطرفيه. والأخيرون ظلوا محل حفاوة ورعاية من السلطة القائمة، خصوصا الذين التقوا مع سياستها المخاصمة للتيار الإسلامي.
وفي ظل ذلك الرضا أو التوافق فتحت الأبواب على مصارعها لرموز ذلك التيار، وجرى تمكينهم من أغلب مواقع التأثير وتشكيل الرأي العام في مجالي الثقافة والإعلام. وأصبح هؤلاء بمثابة الراعي الرسمي للعقل المصري، والممثل الشرعي الوحيد له. وهو الوضع الذي اختلف بعد زلزال ثورة 25 يناير، الذي أسقط الوصاية على الشعب وكسر القيود التي كبلته.
(3)
حين تقدمت الأجيال الجديدة من الشباب صفوف ثوار 25 يناير نسي الجميع هوياتهم وانتماءاتهم. وكانت تلك لحظة تاريخية التحم فيها الجميع حول هدف واحد مشترك، لكن ذلك لم يستمر طويلا. إذ سرعان ما حدث الشقاق حين طرحت التعديلات الدستورية، وجاءت نتيجة الاستفتاء عليها مفاجئة للجميع وصادمة للتيار العلماني.
كانت فصائل وأطياف التيار الإسلامي قد استعادت حضورها بعدما خرجت من جُب الإقصاء والحظر، وبرز ذلك الحضور في صف الداعين إلى تأييد التعديلات، وتصدر العلمانيون والأقباط صف الرافضين لها.
وتحدد وزن كل طرف حين صوت 77٪ لصالح التعديلات، ورفضها 22٪ فقط، بعد ذلك انقسمت مصر إلى ثلاثة معسكرات،
واحد يضم الإسلاميين،
والثاني يضم العلمانيين،
والثالث اصطف فيه الأقباط الذين التحقت أعداد منهم إلى جانب العلمانيين.
اكتشف العلمانيون أن أغلبية المصريين لم تستجب لندائهم ولم تتلق شيئا من خطابهم الذي يبثونه منذ نحو أربعين عاما. فأعادوا إنتاج خطاب الإقصاء الذي اعتمدوه طول الوقت، وأضافوا إليه خطاب التخويف والترويع لجذب الواقفين بين المعسكرات الثلاثة. وأطلقوا في هذه الأجواء فكرة المفاضلة بين الدولة الدينية التي اعتبروها فزاعة الموسم، والدولة المدنية التي وضعوها قناعا لإخفاء، المشروع العلماني.
بالتوازي مع ذلك فإنهم دعوا إلى استمرار المجلس العسكري في السلطة، بحجة أن إجراء الانتخابات الحرة سوف يأتي بالتيار الإسلامي مستصحبا معه فزاعة الدولة الدينية بالشرور الكامنة في جعبتها. وذهبوا إلى حد التنديد بالمجتمع وتقريع أغلبيته التي صوتت لصالح التعديلات.
فمن قائل إنه لا يحسن الاختيار من يعاني الأمية التي بلغت نسبة 40٪،
وقائل إن الواحد ممن قالوا لا بألف واحد من الذين قالوا نعم.
وأطلقت فكرة مضحكة طالبت بأن يعتبر صوت المتعلم ضعف صوت الأمي عند الفرز في الانتخابات.
ودعا بعض «عقلاء» العلمانيين إلى النص في الدستور الجديد على أن يكون الجيش وليس المجتمع حارسا للديمقراطية والشرعية. في استلهام للتجربة التركية التي تجاوزها النظام هناك منذ أربعين عاما.
هذه الأصداء كشفت عن مفارقات جديرة بالملاحظة في مقدمتها ما يلي:
إن النخب العلمانية ظلت متمسكة بموقف الإقصاء الذي تبناه النظام السابق، ومن ثم فإنها اصطفت دون وعي في الأغلب ضمن «فلول» ذلك النظام على الصعيدين السياسي والثقافي.
< إن تلك النخب تحولت بمضي الوقت إلى أصولية أو سلفية علمانية، متخلفة حتى عن التطور الحاصل في العلمانية الليبرالية السائدة في الديمقراطيات الغربية.
< إنها انتقلت تلقائيا إلى صفوف المنددين بالمجتمع والطاعنين في إدراكه. وبدلا من أن تستمد شرعيتها من التعبير عنه، فإنها آثرت أن تضعه في قفص الاتهام وتحاكمه، وبدا أن المطلوب أن يتشكل المجتمع وفقا لرغبات تلك النخبة، لا أن تكون هي مرآة له وناطقة باسمه.
< إنهم أصبحوا يبحثون عن آليات غير ديمقراطية لحماية النظام الجديد، في مسعى غير مباشر لإعادة إنتاج النظام الاستبدادي القديم. وهو ما عبروا عنه بمطالبة الجيش بالبقاء في السلطة لأمد أطول. وباقتراح تولي الجيش ضمان حماية الديمقراطية في مصر.
(4)
لا تقف المفارقات عند ذلك الحد. ذلك أن بعض مدارس التيار الإسلامي التي كانت متوجسة ومتحفظة إزاء الآخر، طورت من نفسها خلال الثلاثين سنة الأخيرة، وأصبحت أكثر انفتاحا وحرصا على مد الجسور والتعايش مع ذلك الآخر.
وتمثل ذلك في انخراطها في صفوف الداعين إلى الديمقراطية والتعددية، التي انحازت إليها دراسات وفتاوى عدة، أبرزها ما صدر عن الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
بالمقابل فإن التيار العلماني الذي بدأ ليبراليا وأعلن تمسكه بالهوية الإسلامية لمصر قبل مائة سنة (كما دلت على ذلك وثائق مؤتمر عام 1911)، فإنه انتهى إقصائيا وسلفيا على النحو الذي نشهده الآن في مختلف نصوص ومواقف المعبرين عنه.
في كتابات المستشار طارق البشري، وكذلك الدكتور عبدالوهاب المسيري، إن عقد الثمانينيات في القرن الماضي شهد بدايات الفرز والفراق بين القوى السياسية في مصر، بل وفي الساحة الدولية أيضا.
ويذكرنا البشري في كتابه «نحو تيار أساسي للأمة» بأن الإخوان المسلمين والشيوعيين أيدوا في انتخابات نقيب المحامين التي جرت عام 1982 شخصية وطنية مستقلة هي الأستاذ عبدالعزيز الشوربجي.
وإن القوى الوطنية كانت لها مواقفها الواضحة قبل ذلك إزاء اتفاقيات كامب ديفيد والقضية الفلسطينية ومشكلة بيع هضبة الأهرام ووضع السلطة القضائية والمحكمة الدستورية وقانون الأحزاب وغير ذلك من القضايا الجامعة.
غير أنه منذ منتصف الثمانينيات دب الخلاف بين الجميع ولاحت بوادر الفراق حين ثار الجدل حول موضوع سلمان رشدي وقصة أولاد حارتنا وقضية تسليمة نسرين ومجلة إبداع ومشكلة نصر حامد أبوزيد.
وهذا الخلاف كانت له أصداؤه التي لاتزال حية إلى الآن.
الموقف أكثر تعقيدا وحدة في المرحلة الراهنة، خصوصا بعد تحديد موازين القوى وظهور الاستقطاب الذي سبقت الإشارة إليه بين التيارات الإسلامية في جانب وبين العلمانيين والأقباط في الجانب الآخر. وليست المشكلة في مبدأ الاختلاف، ولكنها في مداه ومآلاته.
(٥)
في هذا الصدد فلعلي لا أكون مبالغا إذا قلت إننا بإزاء لحظة فارقة. وأن خطاب التعبئة المضادة والتخويف نجح في إقامة ما يمكن أن نسميه بأنه «حاجز نفسي» على الأقل بين التيارات الإسلامية في جانب وبين العلمانيين والأقباط في الجانب الآخر.
إذا كنا جادين في حل الإشكال الخطر، فينبغي أن نتفق أولا على أنه لا مكان للغلاة والمزايدين على طاولة الحل.
نتفق ثانيا على إيقاف الحرب الأهلية والإعلامية المعلنة بين الفرقاء لإتاحة الفرصة للحوار على أساس الاحترام المتبادل.
ينبغي أن نتفق ثالثا على أن إقصاء أي طرف يفاقم المشكلة ولا يحلها فضلا عن أنه يعيدنا إلى مناخ ما قبل 25 يناير.
ينبغي أن نتفق رابعا على أن كل طرف يجب أن يقبل بالآخر كما هو، وألا يطالب بالتنازل عن ثوابته.
أخيرا فإنه ليس أمامنا سوى الاحتكام إلى صناديق الانتخاب الحر، وإن نسلم في ذلك بالقاعدة المعمول بها في كل الديمقراطيات المحترمة. التي تقر مبدأ حكم الأغلبية وحقوق الأقلية حيث لا يستقيم حال ولا يستقر مجتمع تطالب فيه الأغلبية بأن تعيش بشروط الأقلية، حيث يعد ذلك عودة إلى زمن القهر والاستبداد مرة أخرى.
إذا لم تتوافق النخب على ذلك فإنها ترتكب جريمة في حق الوطن وفي حق أهل مصر، لأنها بذلك تدفع بالبلد إلى مجهول لا تحمد عقباه، شروره لا تعد ولا تحصى،
اسألوا الله للجميع الهداية وللوطن السلامة.
...................
May 15, 2011
نريدهم أبطالًا في الفن
صحيفة السبيل الأردنيه الاثنين 13 جمادي الاخره 1432 – 16 مايو 2011
نريدهم أبطالًا في الفن – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/05/blog-post_16.html
حين قرأت قول المخرجة إيناس الدغيدي أن مهمتها هي محاربة الدولة الدينية، فإنني خشيت أن تكون هذه أول ضربة موجعة تتلقاها الدولة المدنية.
وهو ما ذكرني بما ردده البعض قبل حين تعليقا على تصريح لها قالت فيه إنها ستترك البلد إذا تولى الإخوان السلطة، إذ سمعت أحدهم يدعو الله أن يعجل بوصول الإخوان إلى السلطة، معتبرا أن بعض القضاء أخف من بعض.
ولا أعرف مدى دقة هذا الكلام الذي نسبته إليها الصحف في الشأن السياسي، خصوصا أنه يتضمن أخبارا هامة، من قبيل قولها إن لها موقفا لم تتزحزح عنه منذ أول يوم في حياتها وسوف يستمر معها حتى آخر يوم، مضيفة أنها اختارت أن تحارب علنا وبغير هوادة ذلك التيار الذي يوصل الإخوان إلى الحكم.
من تلك الأخبار التي سربتها أيضا أن الإخوان استولوا على الثورة في مصر.
والخبران أذيعا لأول مرة، لأننا لم نسمع بتلك المعركة الشرسة التي تخوضها منذ ولدت ضد التيار الديني (لم تذكر أسلحتها في ذلك). ولم نكن نعرف أنها كانت تموه علينا وتخدعنا باللغط الذي أثارته الأفلام التي أخرجتها والبرامج التليفزيونية التي قدمتها في شهر رمضان لتشجيع الناس على الإفطار، في حين أنها كانت تخوض في هدوء معركتها السرية ضد التيار الديني والدولة الدينية وكان من نتائجها ظهور الجماعات السلفية.
كما أننا لا بد أن نغبطها على إحاطتها بما هو خافٍ على الجميع، حين أسرَّت أيضا لأسبوعية «الفجر» (عدد 16/5) أن الإخوان استولوا على الثورة، وهو ما لم يسمع به حتى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ذاته.
إذا انتقلنا من الهزل إلى الجد، فإنني لا أخفي دهشة سواء من اهتمام الصحافة الفنية بالآراء السياسية للفنانين، ومن الصحف التي تبرز تلك الآراء وتثير بها فضول الناس؛ حيث ليس مطلوبا من هؤلاء أن يصبحوا محللين ولا زعماء سياسيين، وغاية ما يتوقعه الناس منهم أن يقدموا لهم فنا أصيلا وممتعا.
وهو كلام قلته من قبل تعليقا على تورط بعض الفنانين في تصريحات سياسية لم يكونوا مضطرين إليها، ولكني لاحظت أن ظاهرة ركوب الموجة السياسية برزت بعد ثورة 25 يناير. إذ حرص البعض على أن يقدموا أنفسم بحسبانهم أبطالا للثورة وآباء لها، حتى فتش كل واحد منهم في أعماله لعله لوى شفتيه أو امتعض ذات مرة في أحد المشاهد، ليسارع إلى التدليل بذلك على أنه لم يكن راضيا عن الأوضاع وكان معارضا للتوريث.
وإذا ما فشلت مسرحية أو فيلم قدمه آخر فإنه أصبح يبرر ذلك بأن جهاز أمن الدولة هو الذي ضغط وقام بتطفيش الجمهور.
وقرأت أخيرا أن إعلامية كانت قد تركت مصر في أعقاب إشكال أثارته في حلقة تليفزيونية قدمتها حول فتيات الليل، وحين عادت أخيرا فإنها رفعت لواء الثورة وقالت إن حبيب العادلي وزير الداخلية السابق لفّق لها القضية بإيعاز من سوزان مبارك، كأن المشكلة الحقيقية كانت مع زوجة الرئيس السابق ونظامه.
لا أعرف من نلوم، الصحفيين الذين يؤثرون الثرثرة والنميمة وسؤال الفنانين فيما لا يجيدونه، أم الفنانين الذين يسعون إلى ركوب الموجة وتقديم أنفسهم باعتبارهم مناضلين وضحايا.
أزعم أن الطرفين مسئولان، إلا أن مسئولية الصحفيين أكبر لأنهم من يستدرج الفنانين بأسئلتهم التي كانت تركز في السابق حول رأيهم في حظوظ جمال مبارك. وأصبحت تنصب الآن على رأيهم في القوى السياسية ومواصفات رئيس الجمهورية القادم.
وقد تمنيت باستمرار على الفنان إذا لم يكن ناشطا سياسيا، أن يقول إنه لا يجيد الكلام في السياسة وأن اهتمامه بفنه يستغرقه ولا يتيح له متابعة الشأن العام وحسم الخيارات السياسية
أما إذا كان موجودا في الساحة السياسية وله حضوره في أي تجمع سياسي، فإن ذلك يوفر له شرعية تسمح له بأن يكون له رأي في كل ما يجري.
بذات المعيار، فإنني لم أستسغ إدانة بعض الفنانين من غير الناشطين السياسيين، لأنهم لم يؤيدوا ثورة 25 يناير أو أنهم انتقدوها. وأزعم أنه من التعسف والظلم غير المبرر أن يشهر بهم وتدرج أسماؤهم فيما سُمي بقائمة «العار».
ذلك أن أمثال هؤلاء اجتهدوا في حدود إدراكهم وخبرتهم المحدودة بالموضوع، ولا ينبغي أن يوجه إليهم اللوم إذا تبين أنهم وقعوا في خطأ سياسى، بما يؤدي إلى اغتيالهم أدبيا وفنيا ــ وإذا كان المجتهد إذا أخطأ في الدين فله أجر وإذا أصاب فله أجران، فأولى بنا أن نترفق بمن اجتهد وأخطأ في شئون الدنيا، فلا نعاقبه أو نحاكمه.
بالمناسبة، فليس مطلوبا من الفنانين أن يتسابقوا على إنتاج الأفلام التي تمجد الثورة، لكي يلتحقوا بركب المتنافسين على كتابة الأغانى التي اصبحت تقول كلاما واحدا عن أيامنا السوداء وفرحة الثورة ودماء الشهداء.
إن أكبر خدمة يقدمها الفنانون لنا وللثورة، أن يكفوا عن الإفتاء في السياسة، وأن يقدموا لنا فنا نظيفا راقيا وممتعا، وهم بذلك يطلقون ثورة موازية في مجالهم. وإذا فعلوا ذلك فإنهم يؤدون ما عليهم وزيادة.
إذ نحن نريدهم أبطالا في الفن وليس في السياسة. والأولون قلة نادرة والآخرون على قفا من يشيل.
...................
May 14, 2011
حزمة أسئلة مزعجة
حزمة أسئلة مزعجة – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/05/blog-post_15.html
هذه رسالة مهمة حول الموقف الاقتصادي الراهن في مصر تحذر من خطورة الاستدانة من صندوق النقد الدولي، الذي أعلن يوم الخميس الماضي أن مصر طلبت اقتراض ما بين 10 و12 مليار دولار منه. وصاحب هذه الرسالة هو الدكتور محمود الخفيف، الخبير الاقتصادي بالأمم المتحدة، وقد كتبها تعبيرا عن رأيه الشخصي الذي لا علاقة له بالمؤسسة التي يعمل بها.
خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، تراجعت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي من 36 إلى 28 مليار دولار، الأمر الذي يعنى أنه خرج من مصر خلال تلك الفترة ما يزيد على 8 مليارات دولار، تمثل 22٪ من احتياطي البنك المركزي في شهر ديسمبر الماضي.
وتشير التقارير إلى أن السحب الأكبر من الاحتياطى تم بعد انتصار ثورة 25 يناير، وأن أعلى نسبة كانت في شهر مارس الذي تم فيه سحب أكثر من 3.4 مليار دولار في شهر مارس.
والمرجح أن يكون كل ذلك الانكماش له صلته بتهريب الأموال الفاسدة، التي سطت عليها رموز النظام السابق. والغريب في الأمر أنه في مثل هذه الظروف الاستثنائية، وحتى اللحظة الراهنة، لم يعلن البنك المركزي أو وزارة المالية عن مسببات ذلك التراجع، ولم تتخذ أي إجراءات استثنائية للسيطرة على حركة رءوس الأموال، كما فعلت ماليزيا في عام 2008، علما بأن تسريب أموال شعب مصر وعدم اتخاذ أي خطوات لكبحه أمر خطير لا يقل خطورة عن الفساد ذاته.
الأمر الذي لا يقل خطورة عن ذلك هو اللجوء إلى الاستدانة من الصندوق والبنك الدوليين بمبلغ مهول يمثل ما بين 5 و6٪ من حجم الاقتصاد المصري. الأمر الذي يرفع مديونية مصر بمقدار الثلث تقريبا، ويعنى في ذات الوقت أن الحكومة الانتقالية الحالية ستسلم الخزانة خاوية إلى الحكومة التي ستأتى بعدها.
يعني ذلك أيضا أننا نستهلك مما سننتجه في المستقبل، مما يقلل من قدرتنا المستقبلية على الاستثمار، أما إذا واجهنا صعوبة في السداد تحت أي ظرف فإننا قد نواجه بشروط وقيود ربما تهدد أهداف الثورة الساعية إلى زيادة الإنتاج وتوفير العدل الاجتماعي.
إن اللجوء إلى هذه الخطوة يثير أسئلة عديدة منها مثلا:
هل سنعود إلى «إصلاحات» الصندوق والبنك من جديد رغم أننا نعلم أن الجهتين تتبعان أجندة الدول الغربية التي تمتلك الجزء الأعظم من أموال المؤسستين. وهي ذات الدول التي تستقر فيها وتستفيد من الجزء الأعظم من أموال الفساد في العالم الثالث.
ثم هل نحن بحاجة حقيقية إلى تلك القروض؟
وهل درسنا كل سبل سد العجز والتي يجب أن يكون منها مشاركة الشعب والتقشف والحد من أنواع الإنفاق الباذخ؟
وهل من حق حكومة ستذهب بعد أشهر معدودة أن تقترض وتزيد من ديون مصر دون الرجوع إلى الشعب.
ولأن مثل هذه القروض يجب (قانونا) أن يصدق عليها مجلس الشعب، ولأن المجلس محلول الآن، فمن إذن له الحق على التصويت على قروض بهذا الحجم والثقل؟
هل هو مجلس الوزراء، هل هو وزير المالية، هل هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟
هناك أسئلة أخرى من قبيل:
لماذا تزيد ديوننا بما يتراوح بين 10 و12 مليار دولار؟ ومن صاحب القرار في ذلك؟ وأين ستذهب تلك الأموال؟
وهل هي للاستهلاك وتهدئة الشعب وللوفاء بوعود سياسية واستهلاكية، أطلقها بعض أعضاء الحكومة المؤقتة، وليس لدينا القدرة على احتمالها الآن؟ أم أنها لأغراض الاستثمار في الوطن والصناعة والزراعة والتعليم والصحة؟
وما هي الفترة التي ستستخدم وتستهلك فيها هذه القروض؟ وما هي المدة التي ستسدد خلالها؟ وهل لدينا القدرة على السداد في هذه الفترة؟ وما هي شروط هذه القروض ميسرة كانت أو غير ميسرة؟
وقبل كل شيء.. لماذا الصندوق والبنك، أهما الملجأ الأول والأخير؟
ألا توجد سبل أخرى شعبية وطنية وعربية وإسلامية وأفريقية، كبنك التنمية الإسلامي وبنك التنمية الإفريقي ودول عربية وإسلامية وإفريقية صديقة؟
وألا يوجد حل وطني لسد العجز مثل بعض إجراءات التقشف والسيطرة على حركة رءوس الأموال، كما فعلت كوريا الجنوبية وماليزيا في عام 2008 حتى لا يلجآ للصندوق والبنك، وذلك لمعرفتهما بخطورة اللجوء لمثل هذه المؤسسات، والذي عادة ما يؤدي إلى تقويض قدرتنا على تنمية أنفسنا في المستقبل.
لقد اتبعنا «نصائح» الصندوق والبنك لأكثر من 35 سنة. وكانت النتيجة أننا وقعنا في قبضة نظام ليبرالى متوحش من السياسات والنظم الاقتصادية وبرامج خصخصة لأموال شعب مصر، الأمر الذي أدى بشكل مباشر لكل هذا القدر من الفساد والإفساد وسوء توزيع الدخل وسوء التنمية وسوء تعليم وسوء صحة وسوء الأخلاق.
...................
May 13, 2011
فتش عن التمويل
صحيفة الشرق القطريه السبت 11 جمادي الاخره 1432 – 14 مايو 2011
فتش عن التمويل – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/05/blog-post_14.html
وجهت وزارة الخارجية الفرنسية الدعوة إلى ستة من شباب التجمعات السياسية المصرية التي شاركت في ثورة 25 يناير لحضور ندوة في باريس عن التطورات التي شهدها العالم العربي.
وقد حضر هؤلاء الندوة التي عقدت يومي 14 و15 أبريل الماضي. وكان بينهما اثنان أحدهما يمثل الإخوان المسلمين والثاني عن حزب الوسط،
وفيما علمت فإن نائب وزير الخارجية الفرنسي حين حدث المهندس أبو العلا ماضي الأمين العام لحزب الوسط بهذا الخصوص فإنه اقترح عليه أن يرشح الحزب فتاة وليس شابا، لسبب غير واضح بالضبط، ولكن الحزب فضل أن يوفد واحدا من نشطائه، وهو ما كان.
قبل الندوة التي نظمتها الخارجية الفرنسية، تمت دعوة ثلاثة من الشبان المصريين من جانب حزب ساركوزي الحاكم (الاتحاد من أجل الحركة الشعبية) للتعرف على أمانات الحزب والحوار مع ممثليه، فيما وصف لاحقا في الصحافة الفرنسية بأنه «تدريب لشباب الثورة في مصر».
وكان ممثل حزب الوسط طبيب الأسنان يامن نوح أحد الثلاثة، في حين استبعد ممثل الإخوان من هذا البرنامج، في هذه الجولة التقى الشبان الثلاثة بعض كوادر الحزب، في المقدمة منهم شخصيتان مهمتان، إحداهما فالاري هوتنبرج وهي يهودية تعمل سكرتيرة للرئيس ساركوزي لشؤون العلاقات العامة والأحزاب، وجان فرانسوا كوبيه الأمين العام للحزب.
خلال اللقاءات جرت حوارات حول التجربة في فرنسا وحول الأوضاع والتطورات الأخيرة في العالم العربي ومصر بوجه أخص.
وتطرق الحديث إلى الحماس الفرنسي للتطور الديمقراطي والنشاط الأهلي في مصر، واستعداد الحكومة الفرنسية لتقديم مختلف صور العون للجماعات السياسية التي ظهرت أثناء الثورة. في هذا الصدد عبر كل من السيدة فالاري والسيد كوبيه عن رغبة الحكومة والحزب الحاكم في التعاون مع الأطراف التي تتبنى أربع قضايا أساسية هي:
علمانية الدولة المصرية
ـ تأييد معاهدة كامب ديفيد والدفاع عن السلام مع إسرائيل ومعارضة سياسة حركة حماس «الإرهابية»
ـ الدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك ورفض تقديمه إلى المحاكمة
ـ الاصطفاف إلى جانب التيارات السياسية التي تتحالف ضد جماعة الإخوان المسلمين، لإضعاف أي حضور لها في المستقبل السياسي لمصر.
حين جادلهم الدكتور يامن نوح معارضا أطروحاتهم في النقاط الأربع. فإنهم ألغوا زيارة كان مقررا أن يقوم بها الثلاثة للبرلمان الفرنسي، ورتبوا لهم جولة في متحف الهولوكوست، الذي يخلد شهداء اليهود الفرنسيين من ضحايا الحرب العالمية الثانية.
لا الزيارة كانت بريئة ولا المساعدات التي تم التلويح بها كانت لوجه الله، ولكن الأمر كله كان مشروع صفقة، إذا تمسكتم بالعلمانية ووقفتم مع إسرائيل وضد حماس والإخوان فنحن مستعدون للدعم والتمويل ومساعدة هذه الديمقراطية وذاك الاعتدال.
لا مفاجأة في الموضوع. ولا سر نسمع به لأول مرة، فهذا شأن الدعم الأجنبي باستمرار، إذ الأجندة حاضرة مسبقا، فقط الجديد في الأمر أن واحدا تلقى الدعوة ولم يستجب ولم يقبض وتكلم بعد ذلك، في حين أن غيره يسمعون ويتجاوبون ويقبضون في هدوء، ولا يتكلمون، ويبدو أن دائرة السوق اتسعت بعد ثورة 25 يناير. لأننا اعتدنا على أن تقوم دول أخرى في الغرب بمثل هذه العروض.
وكان مفهوما تركيز فرنسا على الشمال الإفريقي وربما لبنان أيضا، لكن من الواضح أن ثمة سباقا غربيا على النفوذ والحصول على موطئ قدم في مصر ما بعد الثورة، فلم تعد الولايات المتحدة ولا بريطانيا أو ألمانيا هي التي تحاول اختراق الساحة المصرية، ولكن هاهي فرنسا دخلت على الخط.
وقال لي أحدهم في الأسبوع الماضي إنه تلقى عرضا إيطاليا لتمويله إذا اشترك في اللعبة، وحين علمت أن غرفة التجارة المصرية الأمريكية هي التي مولت مؤتمرا كبيرا عقد في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة لمعارضة التعديلات الدستورية، فإنني أصبحت أتعامل بحذر مع أكثر التحركات التي تحدث في الساحة المصرية هذه الأيام.
مثل تلك الاختراقات ليست مقصورة على الساحة المصرية، لأن هناك غزوا غربيا لمنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم العربي. وهو ما نشهد نموذجا فادحا له في الضفة الغربية التي تمول الدول الغربية فيها بسخاء شديد أي تجمع فيها يؤيد السلام مع إسرائيل،
إنها أجندة واحدة ترتدي في كل بلد ثوبا مغايرا.
.....................
May 11, 2011
حزمة رسائل من إمبابة
صحيفة الشرق القطريه الخميس 9 جمادي الاخره 1432 – 12 مايو 2011
حزمة رسائل من إمبابة – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/05/blog-post_12.html
نخطئ إذا اعتبرنا أن ما جرى في إمبابة سببه مشكلة عاطفية بين مسلم وقبطية تحولت عن دينها وهربت معه.
ذلك أن هذه المشكلة ليست سوى عود الثقاب الذي ألقي في ساحة مشبعة بالبنزين. بالتالي فإن قضيتنا ليست في العود الذي أشعل الحريق، ولكنها بدرجة ما فيمن أشعل العود وبدرجة أكبر في الساحة الجاهزة للاشتعال والانفجار.
ويكتسب الحدث أهمية خاصة حين يقع في ظل ثورة تعلقت بها عيون وأحلام الملايين في مصر وخارجها ومن ثم يصبح الحدث بمثابة قنبلة انفجرت فجأة في وجه تلك الملايين وفي وجه الثورة ذاتها.
ليس لي أي كلام فيما هو خاص في الموضوع، فلا المسلمون زادوا بتحول السيدة عن دينها ولا الأقباط نقصوا، فضلا عن أن الطرفين خسرا وكان الوطن هو الخاسر الأكبر. وإن كنت أفهم امتعاض العائلات من مثل هذه التحولات، لكني لم أفهم حتى الآن احتجاز المتحولات في بيوت التكريس أو الأديرة، في دولة ذات سيادة ولديها قوانين ومؤسسات حقوقية تحاسب البشر عن أي خرق أو تجاوز.
في ذات الوقت. فلسنا نحن الذين نجيب عن السؤال من أشعل عود الثقاب، وإن كنا نعرف جيدا من صاحب المصلحة في إشعاله. أعني أن سلطة التحقيق وأجهزة التحري والبحث هي الأولى بالكشف عن هذا الجانب. وهي المنوط بها تحديد ما إذا كان التعصب وراء ما جرى، أم أنه البلطجة أم أن لفلول الحزب الوطني يدا فيه، أم أن هناك أصابع أجنبية وراء عملية التفجير. إن تلك كلها أطراف ذات مصلحة مرشحة. لكن ليس بوسعنا أن نحدد مَن مِن تلك الأطراف حضر ومن غاب، وما نصيب كل من حضر فيما جرى.
سيظل ذلك الجانب غامضا إلى أن تنتهي التحقيقات والتحريات وتنجلي تلك الخلفية. لكننا تلقينا مما جرى عدة رسائل من بينها ما يلي:
< إن ثمة غضبا قبطيا وشعورا عميقا بالمرارة، اقترنا بدرجة عالية من الحساسية وسوء الظن. وهي مشاعر قد تكون مبررة، لكن حدودها تظل بحاجة إلى ضبط، بحيث نميز بين ما هو مقبول ومعقول من أسباب الغضب، وما ليس مقبولا أو معقولا. فنحن نفهم مثلا أن ينصب ذلك على ممارسات بعض المسلمين، لكننا لابد أن نستغرب أن يوجه إلى كل المسلمين أو إلى حضور الإسلام في البلد.
< إن السلفيين لم يكونوا الطرف الأساسي في المشكلة. وإذا كان بعضهم قد تواجد أمام كنيسة مارمينا، فإن حضورهم كان ضمن غيرهم من المسلمين الذين تجمهروا تضامنا مع الرجل الذي جاء يبحث عن زوجته التي قيل له إنها محتجزة في بيت «التكريس» المجاور للكنيسة.
< إن قبطيا هو الذي بدأ بإطلاق الرصاص على المتجمهرين وإن طلقات أخرى وزجاجات المولوتوف انهالت عليهم من نظرائه في المنازل المجاورة. الأمر الذي يعطي انطباعا بأنه كان هناك استعداد للتحدي والتصعيد. وذلك تطور نوعي جدير بالملاحظة والانتباه.
< نشرت صحيفة الوفد يوم الثلاثاء 10/5 أسماء 110 من المصابين وجدت أن بينهم 30 قبطيا و80 من المسلمين، الأمر الذي أيد المعلومات التي ذكرت أن المصابين من المسلمين ضعف نظائرهم من الأقباط. وهذه النسبة لم تستوقف أحدا من المحللين أو المعلقين.
على الأقل في البرامج التلفزيونية التي ناقشت الموضوع. وحتى في الحديث عن القتلى الذين توزعوا مناصفة على الجانبين، فإن مقدمي تلك البرامج أبدوا أسفهم لمقتل الأقباط الستة (في رواية أخرى أنهم أربعة فقط) وكانوا محقين في ذلك لا ريب، إلا أنهم تجاهلوا تماما المسلمين الذين قتلوا أيضا. وأهمية هذه الأرقام تكمن في أنها تدعونا إلى قراءة المشهد من زاوية أوسع وربما من منظور مختلف.
< يلفت الانتباه أن كنيسة مارمينا التي قصدها المسلمون في البداية بمظنة أن قسيسها يحتجز الزوجة تعرضت للرشق والتخريب فقط، في حين أن كنيسة العذراء التي توجهوا إليها بعد ذلك أحرقت تماما. ولا تفسير لذلك سوى أن المجموعة حين ووجهت بالرصاص وزجاجات المولوتوف عند الكنيسة الأولى ثم شاع بينهم أن مسجدا أحرق، فإنها قررت الانتقام واستهدفت إحراق الكنيسة الثانية.
< إن الحاضر الأكبر في المشهد كانوا هم البلطجية، أما الغائب الأكبر فكان رجال الأمن. وكان ذلك الغياب أوضح ما يكون حين تبين أن الذين استهدفوا الكنيسة الثانية قطعوا مسافة تجاوزت كيلومترين في مسيرة غاضبة ولم يعترض طريقهم أحد من رجال الأمن.
المشكلة أن عيدان الثقاب كثيرة وأن الساحة المصرية مازالت مشبعة بالبنزين.
.....................
May 10, 2011
تحرير ما جرى
تحرير ما جرى – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/05/blog-post_11.html
اعتذرت يوم الاثنين الماضي عن التعليق على أحداث إمبابة، وكان ردي على من سألوني أنني عاجز عن فهم ما جرى بسبب نقص معلومات الكارثة.
ذلك أن الصحف التي صدرت صبيحة ذلك اليوم (8/5) ركزت على خبر الحريق دون تفاصيله.
فجريدة «الأهرام» ذكرت في عنوانها الرئيسي أن نار التعصب الطائفي تهدد مصر.
وجريدة «الشروق» قالت إن الكنيسة اتهمت فلول الحزب الوطني.
و«المصري اليوم» تحدثت عن أن التطرف يحرق الثورة.
وقالت «الوفد» إنها حرب أهلية في إمبابة.
أما جريدة «الدستور » فقد ذكرت أن شبح السلفية يحرق مصر، وأن «المرتزقة والبلطجية والخارجين عن القانون ارتدوا ملابس السلفيين وأحرقوا (كنيستي) العذراء ومارمينا.
وحتى ظهر الاثنين، كانت معلومات من سألتهم أن قصة السيدة «عبير» مختلقة ولا أصل لها، وأنها كانت مجرد ذريعة للهجوم على الكنيستين واستدعاء الملف الطائفي إلى الواجهة، من خلال التلويح بفزاعة السلفيين الذين حولهم الإعلام إلى «عفاريت» المرحلة.
هذه الصورة بدأت تتغير مساء يوم الاثنين، ثم أصبحت أكثر وضوحا صباح الثلاثاء. إذ مساء الاثنين اتصل أبى هاتفيا من أخبرني بأن شخصية «السيدة عبير» حقيقية وليست وهمية، وأن في الأمر قصة عاطفية مما يتم تداوله هذه الأيام، عن شاب مسلم وقع في غرام قبطية من أسيوط، فغيرت دينها، وهربا بعيدا، حيث تزوجا عرفيا، فظل أخوالها يبحثون عنها حتى خطفوها وسلموها إلى الكنيسة، التي احتجزتها في بيت للمكرسات في إمبابة، وحين علم الزوج المسلم بالأمر ذهب إلى الكنيسة ليسترد «زوجته» وكانت تلك بداية انفجار الموقف.
لم أتأكد من صحة هذه المعلومات إلا حين قرأت صحف صباح الثلاثاء (10/5)، وكان التقرير الذي نشره «الأهرام» عن الموضوع هو الأوفى. إذ أيد قصة الزواج العرفي، وأن الفتاة أشهرت إسلامها في شهر فبراير الماضي، وأن محكمة الأسرة في قويسنا نظرت في شهر مارس قضية رفعتها «عبير» للتفريق بينها وبين زوجها القبطي، الذي وافق أمام المحكمة على طلب التفريق. وقد أجلت المحكمة نظر القضية إلى 29 مايو الحالي.
ذكر تقرير «الأهرام» أيضا أن الزوج توجه إلى الكنيسة مع آخرين ليسأل عن زوجته، فأشاع تاجر مقيم بجوار الكنيسة أن تجمع الشباب المسلم يستهدف اقتحامها. وكان ذلك التاجر (اسمه عادل لبيب) أول من أطلق الرصاص على تلك المجموعة، وأنه حرض الشبان الأقباط على مهاجمة المسلمين. وذكرت المصادر الأمنية أن التاجر سبق اتهامه في عام 1992 بالتحريض على العنف ضد المسلمين. وكان على صلة قوية بالحزب الوطني المنحل في إمبابة.
صحيفة «المصري اليوم» أضافت أن الاثنين ارتبطا بزواج عرفي في شهر سبتمبر الماضي، وتركا أسيوط حيث أقاما في بنها، وأن «الزوج» عاد إلى بيته يوم 5 مارس فوجد أن زوجته اختفت. واتصل به من أخبره بأنها موجودة في البيت المجاور لكنيسة مار مينا في إمبابة، وحين اصطحب آخرين وذهب إلى الكنيسة فإن صاحب المقهى القبطي كان أول من أطلق الرصاص عليهم، الأمر الذي كان بداية لمعركة استمرت أربع ساعات.
صحيفة «الشروق» ذكرت أن عضو الحزب الوطني الذي أشارت إلى اسمه بالحرفين (ع. ل) ــ هل هو عادل لبيب الذي تورط في تحريض شباب الأقباط على الاشتباك مع الشباب المسلم؟ ــ وأنه أشرف بنفسه على تجهيز زجاجات المولوتوف وتوزيعها على المجموعة القبطية.
أضافت «الشروق» أيضا أن مجموعة الشبان المسلمين تظاهروا سلميا أمام الكنيسة، لكنهم فوجئوا بوابل النيران وزجاجات المولوتوف تنهال عليهم. في حين أن الأقباط تحدثوا عن هجوم عدد من المسلمين على الكنيسة، كان بينهم سلفيون. وهؤلاء كانوا يلقون بالأحجار وزجاجات المولوتوف (لم يتحدثوا عن مصدر إطلاق الرصاص). أضاف الشبان الأقباط في التحقيقات أن بعض أئمة المساجد طلبوا من المتظاهرين المسلمين الانصراف دون جدوى. فاضطروا (الأقباط) إلى الدفاع عن أنفسهم وجرى ما جرى.
صحيفة «الوفد» ذكرت أن المسلمين في المنطقة المحيطة فوجئوا بشاب مسلم يقف أمام الكنيسة ويصرخ معلنا أن زوجته التي أسلمت اختطفت واحتجزت داخل الكنيسة، فالتفوا حوله، لكنهم فوجئوا بأن مجموعة من الأقباط صعدت فوق أسطح المنازل المجاورة وأطلقت عليهم الرصاص وألقت عليهم زجاجات المولوتوف.
ونقلت الصحيفة رواية أخرى معاكسة قال فيها الأقباط إن مجموعة من البلطجية اقتحموا الكنيسة بدعوى البحث عن «عبير»، ولم يجدوا مفرا من رد العنف بالعنف دفاعا عن أنفسهم وكنيستهم.
غدًا بإذن الله نحاول أن نقرأ رسالة ما جرى.
...................
May 9, 2011
أيكون الخوف عنوانًا للمئوية الثانية؟ – المقال الأسبوعي
أيكون الخوف عنوانًا للمئوية الثانية؟ – فهمي هويدي – المقال الأسبوعي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/05/blog-post_10.html
إذا جاز لنا أن نقول بأننا عشنا «السكرة» في المائة يوم الأولى من عمر الثورة المصرية، وأننا أفقنا على «الفكرة» مع تباشير المائة الثانية،
فهل يجوز لنا أن نقول بأن النشوة والأمل كانا من عناوين الأولى، وأن «الخوف» مرشح لأن يصبح عنوانا للثانية؟
(1)
إذا قال قائل إن الحكم على الثورة بعد مائة يوم من نجاحها لا يخلو من تعسف وتعجل فلن اختلف معه. ذلك أنه إذا جاز إعمال العرف الذي يقضي ببدء محاسبة أي حكومة جديدة تشكل في ظل أوضاع مستقرة بعد مائة يوم، فإن ذلك لا يجوز حين يتعلق الأمر بثورة شعب أسقط نظاما عاتيا هيمن طوال ثلاثين سنة على مقدرات بلد كبير مثل مصر، وتعين على السلطة الجديدة أن تزيل آثار العدوان على كرامة الشعب الذي تجاوز تعداد سكانه ثمانين مليون نسمة، وأن تضع الأساس لبناء نظام جديد يلبى أشواق تلك الملايين.
ذلك أفهمه، وأعرف أيضا أن القلق وربما الخوف من المشاعر الطبيعية التي تنتاب الكثيرين عقب كل تحول جذري يهز المجتمع ويقلب أوضاعه، سواء كان ثورة أو حربا أو زلزالا.
أعرف كذلك أن الأوضاع لم تستقر بعد قيام الثورة الفرنسية إلا بعد مضى عشر سنوات (من 1789 إلى 1799)، عانت البلاد خلالها من مختلف مظاهر الفوضى والصدامات الدموية. إلا أن الحاصل أن أصواتا عدة ارتفعت في مصر عبرت عن الخوف مما يجرى خلال الأسابيع الأخيرة، التي واكبت نهاية المائة يوم الأولى. فقرأنا كتابات عدة تحدثت عن سرقة الثورة وإجهاضها واحتمالات تصفيتها. وحذرت كتابات أخرى من ألاعيب فلول النظام السابق، ومن تفريغ الثورة من مضمونها بحيث تتبخر روح يناير، لتلحق بروح حرب أكتوبر التي تبخرت.
وعبر البعض عن خشيته من تحول الثورة إلى «فولكلور» يحتل مكانه في الذاكرة، دون أن تصبح واقعا يترجم على الأرض، إلى غير ذلك من الرسائل التي تشترك في ثلاثة قواسم مشتركة هى:
أنها أصدرت أحكاما يغلب عليها التشاؤم،
وأنها ركزت على النصف الفارغ من الكوب وتجاهلت النصف الملآن،
كما أنها سلطت الضوء على الحوادث التفصيلية التي تناولتها الصحف ولم تلق بالا للتحولات الاستراتيجية التي حدثت في البلد.
(2)
لا يستطيع أحد أن ينكر أن الإعلام لعب دورا أساسيا في إشاعة مناخ التوجس والخوف، سواء عن طريق المبالغات التي كثيرا ما يلجأ إليها، أو الشائعات التي تسعى بعض صحف الإثارة لترويجها، خذ مثلا ما حدث بقنا في شهر أبريل الماضي، حين اشتبك بعض الأشخاص مع رجل تصادف أن كان قبطيا وقيل إنه يمارس أفعالا منافية للآداب، وأثناء الاشتباك أصيبت أذنه بقطع، فنشرت إحدى الصحف على صدر صفحتها الأولى أن السلفيين طبقوا الحد على الرجل وقطعوا أذنه. وكان النشر بهذه الطريقة نموذجا لسوء التقدير وتعمد الإثارة، لأنه لا يوجد حد في الشريعة بهذا الخصوص، ثم إن الذين اشتبكوا مع الرجل كانوا أكثر من عشرة أشخاص بينهم سلفي واحد، وجاء تحركهم غيرة على الشرف في الصعيد بأكثر منه غيرة على الدين.
والمدهش في الأمر أنه بعد اتضاح الحقيقة فإن بعض الكتاب لا يزالون يستشهدون بالحادث بتفاصيله المضللة، ومنهم من أصبح يتحدث عن «تقطيع آذان الأقباط». الأمر الذي لابد أن يؤدي إلى إثارة مخاوفهم وترويعهم. هذا التلفيق حدث أيضا مع خبر مكذوب تحدث عن رفع السلفيين الأعلام السعودية في أحد مساجد قنا. ورغم أن الخبر لا أصل له، فإن البعض لا يزال يتداوله ويناقشه باعتباره حقيقة وقعت بالفعل.
لم ينافس أخبار تخويف الأقباط غير شائعات إثارة الفزع من الجماعات الإسلامية من خلال بث الأخبار المكذوبة، التي تحدثت مثلا عن خطف الفتيات غير المحجبات من الشوارع. وتآمر المملكة العربية السعودية لمساعدة وتمويل التيارات الإسلامية لاكتساح الانتخابات القادمة، فتحدثت بعض الصحف عن مخطط لتسريب 3 مليارات دولار إلى داخل مصر لهذا الغرض، ولأن الكلام بالمجان فقد رفع آخرون الرقم إلى خمسة مليارات، لا أحد يعرف كيف يمكن أن تدخل إلى البلد، ولا كيف ستصل إلى أهدافها.
وإلى جانب هذه الرسائل المريبة ثمة رسائل لا حصر لها تتحدث عن التأهب لإقامة الحكم الإسلامي وتطبيق الحدود الشرعية، وكانت تلك مقدمات أثارت جدلا واسعا حول المخاوف من إقامة الدولة الدينية، وعن ضرورة إقامة الدولة العلمانية، لتتولى التصدي لـ«تسونامي» تلك الدولة التي يتخوفون منها.
إلى جانب التحريف والاختلاق كانت هناك المبالغات التي عمد أصحابها إلى اصطياد الأخبار والتصريحات والنفخ فيها لتوسيع دائرة الخوف والقلق. وركزت تلك المبالغات على موضوعين أساسيين هما:
موقف الجماعات الإسلامية والعلاقة مع الأقباط. فحين يتورط بعض السلفيين في هدم ضريح في إحدى محافظات الدلتا يصور الأمر بحسبانه اجتياحا سلفيا يهدد ضريح الإمام الحسين والسيدة زينب وجمال عبدالناصر، وحين تعلق لافتة يتيمة في الإسكندرية تعتبر التصويت لصالح التعديلات الدستورية واجبا شرعيا، لا أحد يذكر الخبر كما هو، ولكن تقوم الدنيا ولا تعقد بدعوى أن الإخوان يستخدمون الدين للتصويت لصالح الاستفتاء.
«لا أحد يشير إلى أن الكنيسة القبطية طلبت من رعاياها معارضة التعديلات».
بنفس الأسلوب تم التعامل مع أخبار الأقباط، فإذا اختلف اثنان لأي سبب وقتل المسلم قبطيا عُد ذلك اضطهادا يبرز على الصفحات الأولى من الصحف، وسببا قويا لتجديد الدعوة إلى علمنة الدولة والمطالبة بإلغاء المادة الثانية من الدستور «التى تتحدث عن مرجعية مبادئ الشريعة الإسلامية»، أما إذا قتل المسلم لأنه تزوج من قبطية غيرت دينها كما قتل أولاده منها، فإن ذلك يعد خلافا عائليا يرحل إلى صفحات الحوادث الداخلية!
(3)
هذه التعبئة الإعلامية وسعت من دائرة الخوف في المجتمع. وكانت الثورة، قد استصحبت مخاوف لها أسبابها المفهومة، فثمة خوف حتى من تداعيات الموقف الاقتصادي، خصوصا بعدما تبين أن مصر تخسر شهريا ثلاثة مليارات من الدولارات، وثمة خوف لدى المستثمرين الذين أوقفوا استثماراتهم أو سحبها بعضهم تحسبا للمستقبل. وهذا الخوف كان ولا يزال له صداه في البورصة التي انخفضت أسعار الأسهم فيها، هناك خوف آخر لدى أصحاب المصانع المحلية من الإضرابات العمالية التي طالبت بتعديل الأجور، كما أن البلطجية والهاربين من السجون أشاعوا درجات مختلفة من الخوف خصوصا في المدن النائية وأحياء الأطراف.
إضافة إلى كل ما سبق أشاع الاصطياد والترويع الإعلامي أسبابا أخرى للخوف. خوف الأقباط من المسلمين عامة والسلفيين بوجه أخص. وخوف العلمانيين من الإسلاميين، وخوف المتصوفة من السلفيين، وخوف الجميع من فلول النظام القديم.
أسوأ ما في هذه المخاوف أنها زعزعت ثقة الناس في مستقبل الثورة، وأنها صرفتهم عن مشروعها الأساسي الذي بدأ طامحا للدفاع عن الحرية والعدالة الاجتماعية. هذا الانفراط ضرب الإجماع الوطني حتى كاد يقسم البلد ويوقع بين قواه الحية، ليس ذلك وحسب، وإنما تحولت هذه الحزمة من المخاوف إلى عناصر توحي بعدم استقرار المجتمع، وإلى قوة طرد للاستثمار الأجنبي وللسياحة.
(4)
في تحليل ملابسات المشهد هناك أسباب منطقية تتصل بطبيعة التفاعلات التي تحدث عقب كل ثورة، أو تحول سياسي واجتماعي جلل من قبيل ما سبقت الإشارة إليه. وهناك أسباب تتحمل مسؤوليتها النخبة صاحبة الصوت العالي في الفضاء السياسي والإعلامي. إذ من الطبيعي أن تتأثر بصورة مؤقتة السياحة والاستثمار الأجنبي والبورصة إلى أن تستقر أحوال البلد ويطمئن أصحاب رءوس الأموال على ثرواتهم ويطمئن السائح إلى أن شيئا لن يفسد عليه عطلته. لكن من غير الطبيعي أن تشيع الفوضى في البلد وأن يشوه الإدراك العام، بحيث ينفرط عقد المجتمع ويشيع فيه الانقسام، بما يفقده «بوصلته» الهادية.
العوامل الأولى لا نملك لها ردا ويفترض أنها محدودة الأجل في كل الأحوال، أما الذي ينبغي أن نتصارح بشجاعة في شأنه فهي تلك العوامل الثانية التي صنعناها بأنفسنا. في هذا الصدد أزعم أن هناك طرفين يتحملان مسؤولية إثارة الفوضى وشق الصف الوطني، أحدهما خفي لا نراه يتمثل في فلول النظام السابق وأي عناصر أخرى داخلية أو خارجية لها مصلحة في ضرب الثورة، أما الطرف الثاني فظاهر في الصورة ويتمثل في عناصر النخبة المصرية المهيمنة على وسائل الإعلام، التي باتت تلعب دورا مهما في تشكيل الإدراك العام، وفي الضغط على القرار السياسي.
في تحليل هذا الدور الأخير، أزعم أن أول شرخ في جدار الإجماع الوطني بعد الثورة حدث بعد تشكيل لجنة تعديل الدستور، التى رأسها المستشار طارق البشرى وتبين أن من بين أعضائها رجلا قانونيا من جماعة الإخوان المسلمين. وهو ما فاجأ شريحة المثقفين الذين اعتبروا أن إقصاء الإخوان هو الأصل في السياسة المصرية.
وقد تعرض هذا القرار لهجوم شديد لا يزال مستمرا حتى الآن، رغم أن اللجنة أنهت عملها ولم تعد قائمة منذ شهرين تقريبا. إذ لم يغفر للمجلس العسكري هذه «الخطيئة»، وتجاهل كثيرون صفة الرجل القانونية وكونه كان عضوا باللجنة التشريعية بمجلس الشعب. وقد شاركت في اجتماع للمثقفين مع ثلاثة من أعضاء المجلس العسكري، تعرضوا فيه لنقد شديد من جانب بعض المثقفين بسبب ارتكاب تلك «الخطيئة»، حتى وجه إليهم اتهام بمحاباة الإخوان، وسئلوا عن عدد أعضاء المجلس الموالين للجماعة.
فى هذا الصدد أزعم أيضا أن بعض المثقفين حددوا موقفهم من رفض التعديلات الدستورية لمجرد أن للإخوان عضوا في اللجنة وأن رئيسها لا ينتمي إلى الإخوان حقا، لكنه مسلم ملتزم ولا يعاديهم. وكان الجدل حول هذه النقطة مثار اللغط والطنين الذي أثاره المثقفون، حتى حين أيد التعديلات 77% من المصوتين وعارضها 22% فقط. ومنذ ذلك الحين حدث أمران،
أولهما أن أعضاء المجلس العسكري تجنبوا إشراك الإسلاميين في أي تشكيل يصدرونه، لتفادى نقمة المثقفين وتشهيرهم. وكان ذلك أوضح ما يكون في تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، حتى قلت إن الذي يدير الإعلام ويوجه السياسة منذ ظهرت نتائج الاستفتاء، هم عناصر الـ22% وليس أهل الـ77%.
الأمر الثاني، أن المجتمع انقسم على نفسه وأصبح هناك ما يمكن أن نسميه حربا باردة ثقافية وسياسية.
بحيث لم تعد القضية كيف تحقق الثورة أهدافها، وإنما كيف يمكن محاصرة التيار الإسلامي وإبعاد شبحه الذي يلوح في الأفق من خلال دعوة الانحياز للدولة المدنية ضد الدولة الدينية، في إعادة إنتاج لنموذج الخطاب الذي كان سائدا قبل 25 يناير.
إن التحدي الذي يواجه الثورة والوطني الآن هو كيف يمكن أن يتفق الجميع على المشترك الذي يخرج البلد من أزمته السياسية الراهنة، التي لا تقل خطورة عن الأزمة الاقتصادية. إذ يبدو أن الأخيرة أخف وطأة، لأن صراع العلمانيين والإسلاميين يبدو أنه تحول إلى «عاهة» تستعصي على العلاج. وذلك سبب آخر للخوف، لأن الوطن سيكون الخاسر الأكبر في هذه الحالة.
...................
May 8, 2011
نريده زئيراً لا نُباحاً
صحيفة الشرق القطريه الاثنين 6 جمادي الاخره 1432 – 9 مايو 2011
نريده زئيراً لا نُباحاً – فهمي هويدي
http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2011/05/blog-post_09.html
تزف إلينا صحف الصباح كل يوم أخبار ميلاد حزب جديد، يستلهم مبادئ وأهداف ثورة 25 يناير، أو يقوم على أكتاف بعض الشباب الذين أسهموا في الثورة.
ولا أجد غضاضة في ذلك الحماس الذي يدفع البعض إلى تأسيس حزب لهم، وأعتبر أن ذلك مؤشر على حالة من الإيجابية السياسية طرأت على المجتمع المصري بعد ثورة 25 يناير. إذ بعد سنوات العزوف عن السياسة والاستقالة منها، التي ظل «الحزب الوطني» خلالها محتكرا للسياسة وفارضا نفسه بقوة الأمن ممثلا وحيدا لشعب مصر، قدر لنا أن نشهد ذلك الحماس والتنافس على الانخراط في السياسة والحماس للمشاركة في العمل العام.
إن شئت فقل إن المصريين اكتشفوا بعد سقوط نظام مبارك أنهم استعادوا بلدهم، وأنهم أصبحوا مسؤولين عن إصلاحه وتسيير أموره، فاتجهوا إلى الوفاء باستحقاق تلك المسؤولية.
من ناحية أخرى، فليس لدي قلق من كثرة عدد الأحزاب، حيث أعتبر أن ذلك أمر طبيعي، وصحي أيضا. ذلك أنه بعد سنوات احتكار السياسة وإقصاء المجتمع وازدرائه، لا غرابة في أن يسعى المجتمع بواسطة ناشطيه لتعويض ذلك الحرمان، وإن ببعض الهرولة، وقد سبق أن ذكرت أنه بعد الحرب العالمية الثانية التي انكسرت فيها اليابان عقب إلقاء القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناجازاكي، تسابق الناشطون على النهوض بالبلد، وتشكل حينذاك 400 حزب، ظلت أعدادها تتناقص بمضي الوقت من خلال الممارسة حتى أصبحت الآن 12 حزبا، أقواها حزبان فقط يتداولان السلطة.
من هذه الزاوية فلا قلق من تعدد الأحزاب أو كثرتها، وطالما أن الجميع سيحتكمون في نهاية المطاف إلى صناديق الانتخاب، وسيتنافسون في جو من النزاهة والحرية، فإن ذلك يعني أن المجتمع هو الذي سيقرر الأحزاب الجديرة بالبقاء والاستمرار، وتلك التي ينبغي أن تختفي أو تأتلف مع غيرها.
لا أستطيع أن أخفي حفاوتي بأي أحزاب تخرج من رحم المجتمع وتعبر عن شيء فيه، بخلاف الأحزاب الوهمية الراهنة التي خرجت من مكاتب جهاز أمن الدولة وظلت ذيلا للحزب الوطني الحاكم في النظام السابق، لكن ذلك لا يمنعني من تحذير القائمين عليها من الوقوع في فخ التمويل الحرام الذي تلوح به بعض الجهات الغربية في الوقت الراهن، بدعوى «دعم الديمقراطية» (الولايات المتحدة وحدها رصدت 150 مليون دولار لهذا الغرض). ذلك أنني أتمنى ألا ننتقل من الأحزاب المغشوشة إلى طور الأحزاب المخترقة، خصوصا أن سماسرة دعم الديمقراطية ظهروا في القاهرة خلال الأسابيع الأخيرة ويتحركون الآن بهمة لترويج بضاعتهم.
عندي بعد ذلك ثلاث ملاحظات على الأحزاب الجديدة التي نشأت حتى الآن على الأقل:
< إنها قاهرية بالدرجة الأولى. بمعنى أنها تركز على جمهور العاصمة، وليس لها حضور يذكر في الدلتا أو الصعيد. وأخشى أن يكون السبب في ذلك ليس صعوبة أو كلفة التجول في الأقاليم، وإنما أيضا القرب من دائرة الضوء ووسائل الإعلام، ولا أقول من مقار السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية.
< إنها تتشابه في برامجها. ذلك أن أهداف ومبادئ ثورة 25 يناير تكاد تكون واحدة، بالتالي فإن الفروق لا تكاد تذكر بين الأحزاب التي يفترض أن تستلهم تلك الأهداف والمبادئ. لذلك فإنه سيكون من الصعب على المواطن العادي ــ أو حتى الناشط السياسي ــ أن يختار بين حزب وآخر، نظرا لتشابه برامجها. وهو ما يعني أن معايير الانضمام إلى حزب دون آخر ستكون شخصية أو جهوية أو فئوية، ولن تكون سياسية أو موضوعية.
< إن تعدد تلك الأحزاب إذا كان سيثري الحياة السياسية، فإنه سيضعف تلك الأحزاب كثيرا إذا لم تأتلف فيما بينها عند خوض المعركة الانتخابية، إذ إن أصوات المؤيدين لثورة ومبادئ ثورة 25 يناير ستتوزع على الأحزاب، الأمر الذي لن يمكِّن أيا منها من الحصول على نسبة عالية من الأصوات.
وأحسب أن صيغة ائتلاف شباب الثورة الذي ضم 8 قوى أساسية أثناء الاعتصام في ميدان التحرير، بينها 4 حزبية وأخرى مثيلة لها غير حزبية، يمكن أن تشكل نموذجا ناجحا لترتيب خوض الانتخابات البرلمانية،
ذلك أن ائتلاف أحزاب الثورة، إذا أعلن فإنه يمكن أن يصبح منافسا قويا لأي حزب كبير يخوض الانتخابات، لأن وهج مبادئ الثورة لا يزال يحتل مكانته الرفيعة في الإدراك العام رغم مضي أكثر من ثلاثة أشهر على الثورة. وأذكِّر هنا ببيت الشعر الذي أطلقه أحمد شوقي يوما ما، وقال فيه:
صوت الشعوب من الزئير مجمع فإذا تفرق كان بعض نباح
إننا نريد صوت جماهير ثورة 25 يناير زئيرا يتردد في الفضاء، وليس نباحا تلتقطه الأسماع بصعوبة.
...................
فهمي هويدي's Blog
- فهمي هويدي's profile
- 1314 followers