عبـــــــدالله خلــــــــيفة's Blog: https://isaalbuflasablog.wordpress.com , page 82
January 17, 2021
عبـــــــدالله خلــــــــيفة : الدكتور عبدالهادي خلف مناضل أم ساحر؟
26-11-2003
لا أحد يعرف بالضبط من هو الدكتور عبدالهادي خلف، هل هو (ملا) يعيش في السويد أم باحث اجتماعى؟ هل هو دينى أم علمانى؟ يساري أم يميني؟ باحث في علم الاجتماع أم ساحر له بركات وتأتيه الكشوف؟
هل هو بحرينى يعيش في السويد أم سويدي غادر البحرين؟ هل هوعالم الاجتماع الذي لم يكتب شيئاً في علم الاجتماع, أم مناضل الفاكسات الذي يحدد لشعب البحرين كيف يناضل وما هى الخطوات التي عليه اتباعها وإلا أمطره بسيل جديد من الفاكسات التى تكرر أسلوب البيانات المقتضبة الصادرة من عليم خبير لا يُرد قضاؤه؟
إذا كان الدكتورعبدالهادي خلف من القليلين الباقين على أسلوب الخطب والبيانات الموجزة التي تحدد كل شيء، فذلك لأنه لم يكن يناضل أو يبحث خلال العقود الماضية، ولم يعد قادراً على متابعة وتحليل الأوضاع.
في بداية السبعينيات نزل عبدالهادي خلف بمظلة سياسية من السماء حين كانت هناك فترة سياسية نشطة، احتاج الشعب فيها إلى زعماء نشطين لخوض الانتخابات البرلمانية، وكان الزمن زمن اليسار, فتوجه عبدالهادي غير المعروف إلى اليسار فوراً، الذي احتضنه وحشد له الجمهور في الندوات ولصق صوره في الحارات ونشر اسمه بين الأهالي وجمع له الأصوات، واستنكر بشدة مؤامرة طرده من المجلس الوطني، واحتضنه في السجن وقد قاوم عبدالهادي خلف حينذاك مقاومة كبيرة فأضرب عن الطعام مع رفاقه الذين وصلوا إلى حافة الموت.
وبعد ذلك حين خرج من السجن وكانت بعض جوانب الحياة السياسية تتسم بالفوضى والمغامرات والمؤامرات، نصح الدكتور عبدالهادي المناضلين بضرورة الابتعاد عن هذا النهج السياسي المتطرف، وطرح خطاً عقلانياً لنمو النضال الوطني عبر التدرج ومواكبة الإنجازات الديمقراطية الصغيرة لتتحول إلى تغيير كبير مستقبلاً.
ثم توارى في الخارج، ولم نكد نسمع به خلال عقد من السنين، وكنا نتوقع بأنه مشغول بالبحرين بحثاً وتحليلاً، وأن ثمة دراسات كبرى سوف تنهال علينا من هذا الصمت والعزلة والدرس، ولكن شيئاً من ذلك لم يأتِ من جهته الهادئة.
وبعد ذلك حين برزت الحركة الدينية عاد إلى الوجود، وأخذ ذلك الثوب اليساري الفضفاض يتمزق، وتوجه إلى أقصى احتمالات هذه الحركة، رافضاً ذلك الطرح العقلاني الذي كان يطرحه في ومضات من الكلمات، والذي لم يتأصل بحثاً ولا منهجاً.
كان هذا الموقف يعكس ثمرة الغياب عن الدرس الموضوعي للحياة الاجتماعية المحلية والعربية، فالعناصر العلمانية والديمقراطية في خطابه كانت تطفو على وعي هلامي غير محدد وغير متجذر في نظرة أو أرض، ينجذب بدوافع ذاتية نرجسية نحو مغناطيس الحركة الاجتماعية المنتشرة، سواء كانت يساراً أم يميناً، وسواء قادها تقدميون وطنيون أم دينيون مذهبيون، وسواء راكمت إنجازات ديمقراطية وطنية توحيدية للشعب, أم كانت نهجاً طائفياً غير قادر على خلق نضال حقيقي.
ان هذا النهج الذاتي المتضخم لا يمكن أن يتشكل فكراً، لأن الفكر وثمار الوعي المكتوبة والمنجزة، تغدو حفراً في واقع، وارتباطاً بناس، وتكوين علاقات، وبالتالي تغدو مسئولة ومحددة، تزيدها علاقتها بالواقع والبشر مزيداً من التأصل والمسئولية.
كذلك فإن الدراسات التي لم تظهر كان يمكن ان تعرفه بشعب البحرين والمنطقة: أشكال وعيه وتراثه وسبل تطوره، وقوانين تحوله.
إن هذا الجهد الذي لم يُبذل، والعرق الفكري الذي لم يتصبب، واستمرارالرغبة النجومية في الظهور، إن هذه كلها دفعته إلى المنزلق الفكري الخطير السابق ذكره، وهو أن يتحول إلى دكتاتور بحرينى سويدي يحدد سبل التطور عبر جمل مقتضبة وبيانات ينبغى أن تطاع وتنفذ، لا أن يصير دكتوراً يبحث ويغرس مشرطه في الواقع عميقاً، ويكتشف سبل التطور السياسي المعقدة والمركبة، لكن هذه كانت مهمة مستحيلة في وعي لا يريد أن يتعب.
يريد الدكتور عبدالهادي خلف أن يقودنا إلى مهمات كبرى وتحولات ونحن بعد لم نكد نخطو في عملية إعادة الديمقراطية. وإذا لم يتم التوجه إلى هذه المهمات الكبرى الخلافية، فيعني ذلك بأن القوى السياسية الوطنية البحرينية خانت مواقفها وتاريخها.
وهو يصدر أوامره العليا من منتجعه بالسويد لا يعرف كيف تتشكل الجمعيات السياسية، وبأي أحجار صعبة تنمو، وكيف أن الجمعيات مسألة أعضاء واشتراكات بسيطة رمزية لا تدفع، ومقرات مكلفة، وكوادر شبه نادرة في الإعلام والتنظيم والثقافة والطباعة، وهي روابط مع الناس لا تتشكل بسهولة بسبب القيود الكثيرة المفروضة على نموها وتحركاتها.
إضافة إلى هذا النمو العسير للجمعيات الوطنية هناك حشود من الجمعيات المذهبية والعادية والتي لا تعرف ما هي السياسة والوحدة النضالية والعملية السياسية الإصلاحية المتدرجة. وبعضها يشارك الدكتور عبدالهادي خلف في الوعي السحري: كن فيكون، يشاركونه في خلق الديمقراطية المجلوبة على طبق من ذهب، ولا يعنون بها سوى ديمقراطية لهم لا عليهم.
والذي لا يريد عبدالهادي أن يبحثه بعلم الاجتماع المعطل لديه إنه في خلال أربع سنوات من التحولات في البحرين تمت أشياء كثيرة، وبدأ شعب جديد يتشكل، ووعي مختلف ينشأ، ورغم مؤامرات المحافظين ومغامرات المراهقين، والكم الهائل من العصي التي توضع في دولاب الديمقراطية السائر ببطء، فإن تيارات سياسية كثيفة بدأت تتكون وتشكل صلاتها مع الناس، وبدأت النقابات والجمعيات المهنية في الظهور، وجرت الآف الندوات الفكرية والسياسية الخ..
ولا يمكن أن تتطور الديمقراطية إلا من خلال المسارات التي اكتسبتها قانوناً ودستوراً، ولا تصلح إلا بالمزيد من الديمقراطية، ومن خلال المؤسسات لا من خلال المنح، ومن خلال إرادة الناس الموحدة التي تتجلى في وحدتهم وإرادتهم الانتخابية والنضالية المختلفة.
فالتطور والنضال ليسن سحراً بل إرادة جماعية للشعب، الذي يقرر عبر النضال الطويل الأمد، والتصويت، والحوار، والصراع، والنقد، وتشكيل الجمعيات السياسية الموحدة والتكوينات المتطورة، سبل الإصلاح الأكثر عمقاً.
لكن هذا كله يحتاج إلى تراكم خبرة، ونضوج ووعي، لا يتحققان إلا من خلال إرادته الذاتية، وليس من خلال الإرادات الطائفية المتفرقة والمدمرة، بل من خلال إرادة وطنية، تتشكل بالوعي وتتجسد في التصويت، وهذا أمر يحتاج إلى زمن موضوعي، فليس هو بيضة تقلى، أو دكان يُفتح، بل إلى عدة انتخابات بلدية، وعدة انتخابات برلمانية، أي إلى صبر سياسي طويل، وإلى تراكم نضالي شاق، لا يصبر عليه دعاة السلق السياسي ومحبو النجومية والمنتفخون بذواتهم العظيمة!
وما تفعله بيانات عبدالهادي وغيره من عشاق حرق المراحل سوى أن تعطى صورة مشوهة عن النضال الوطني، وتقدم المبررات للمحافظين وكارهي الديمقراطية في البحرين والمنطقة بان البحرينيين مستعجلين جداً وفوضويين ولا يصلحون للعمل الديمقراطي المنظم والصبور.
لم تتحقق الديمقراطية الأوربية خلال أربع سنوات أو عشر أو مائة سنة! بل تشكلت عبر عدة قرون، ولم تحدث من خلال فاكسات بل من خلال دور الناس والمثقفين في الأزقة و عبر الإنتاج الفكري والسياسي الطويل، وعبر تشكل النقابات والأحزاب ونضالها وتغلغلها في عروق الأحياء.
وفي خلال أربع سنوات، هي ومضة في عمر الزمن، تحققت أشياء كثيرة، وانفتحت سبل النضال النقابي والعمالي والاجتماعي المختلفة عبر قنوات شرعية، وفي إطار من المسئولية، ورغم مشكلات الجمهور الحادة فى بعض القطاعات فقد صبر تقديراً منه لأهمية التحولات، مدركاً أهمية الصندوق الانتخابي الذي وُجد وأهمية تطويره عبر الزمن، فعبر الأصوات يمكن تغيير جوانب من الحياة وإحداث التراكم المطلوب، وعبر النقابات المسئولة والجمعيات السياسية المتشكلة تواً، يمكن رسم صورة المستقبل عبر الصراع السياسي المنظم والقانوني.
أما البيانات السحرية والإرادة السامية من قبل بعض المهاجرين السياسيين فهي تعرقل ولا تفيد، تشجع التطرف اليميني ولا تصبر على العظم الرخو للحياة السياسية الوليدة.
لا نريد من هؤلاء سوى العودة إلى أحيائهم الشعبية وممارسة رجيم سياسي بين الناس، للنضال داخل الحارات العتيقة والجديدة، بدلاً من شحم الغربة والاغتراب.
__ATA.cmd.push(function() { __ATA.initDynamicSlot({ id: 'atatags-26942-6004c5ba9d15e', location: 120, formFactor: '001', label: { text: 'الإعلانات', }, creative: { reportAd: { text: 'الإبلاغ عن هذا الإعلان', }, privacySettings: { text: 'الخصوصية', } } }); });January 5, 2021
عبÙÙÙÙÙÙÙداÙÙÙ Ø®ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙØ© : رÙاÙØ© بÙرترÙÙ Ùصاب

ÙصÙ٠٠٠رÙاÙØ© بÙرترÙÙ Ùصاب ÙÙÙاتب ÙاÙرÙائ٠عبÙÙÙÙÙÙÙداÙÙÙ Ø®ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙØ©
اتبع اÙرابط :
https://reader.thatsbooks.com/yoyue/treader/2/35277?locale=ar_SA
عبـــــــدالله خلــــــــيفة : رواية بورتريه قصاب

فصول من رواية بورتريه قصاب للكاتب والروائي عبـــــــدالله خلــــــــيفة
اتبع الرابط :
https://reader.thatsbooks.com/yoyue/treader/2/35277?locale=ar_SA
عبـــــــدالله خلــــــــيفة : رواية هدهد سليمان
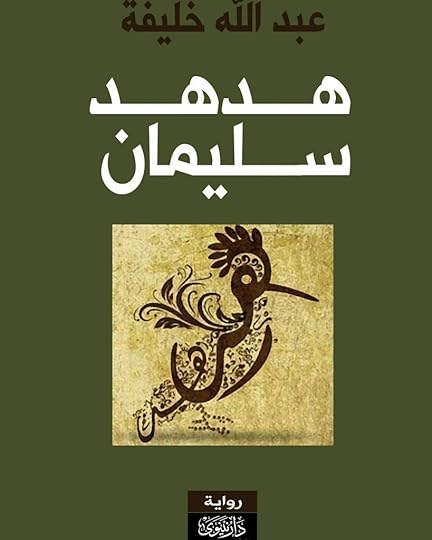
فصول من رواية هدهد سليمان للكاتب والروائي عبـــــــدالله خلــــــــيفة
اتبع الرابط :
https://reader.thatsbooks.com/yoyue/treader/2/45886?locale=ar_SA
عبـــــــدالله خلــــــــيفة : رواية اغتصاب كوكب

فصول من رواية اغتصاب كوكب للكاتب والروائي عبـــــــدالله خلــــــــيفة
اتبع الرابط:
https://reader.thatsbooks.com/yoyue/treader/2/35375?locale=ar_SA
عبـــــــدالله خلــــــــيفة : رواية حورية البحر
فصول من رواية حورية البحر للكاتب والروائي عبـــــــدالله خلــــــــيفة
اتبع الرابط:
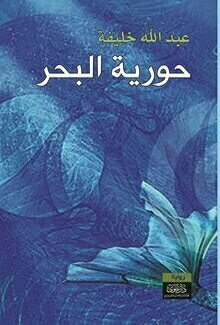
https://reader.thatsbooks.com/yoyue/treader/2/35281?locale=ar_SA
عبـــــــدالله خلــــــــيفة : ضوء المعتزلة

روايات قصيرة من مجموعة ضوء المعتزلة للكاتب والروائي عبـــــــدالله خلــــــــيفة
اتبع الرابط:
https://reader.thatsbooks.com/yoyue/treader/2/35338?locale=ar_SA
January 4, 2021
عبـــــــدالله خلــــــــيفة : #جذور_الرأسمالية_عند_العرب

فصل من كتاب: رأس المـــال الحـكومــــي الشـــــــــــــرقي
لا تسعفنا المصادرُ في الحديث عن وجود أو عدم وجود العمل المأجور ومدى حضوره في العصر الجاهلي والإسلامي الأول، رغم أنها مسهبة في تعداد الثروات الخاصة وظهور القطائع، وهي الشكلُ المبكرُ للإقطاع العربي، وتحدد العلاقات التجارية وطرقها والعلاقات الاجتماعية – السياسية المصاحبة لهذه التجارة، وكذلك تذكرُ الموادَ الأولية العربية والحرفَ المُقامة عليها، ومن هنا من الصعوبة بمكان معرفة طبيعة رأس المال الجاهلي ــ الإسلامي.
في البدء لا بد من معرفة المواد الأولية وهي السلع التي سوف تدخل السوق، وقيم هذه السلع، ومن أي عمل بشري أُنتجت، وماذا يحدث لهذه القيم في السوق، والأثمان التي يأخذها الوسطاء، ونوعية هذه السلع وأسباب نموها بهذا الشكل أو ذاك.
ومن الواضح بأن جغرافيا الجزيرة العربية هائلة، وأن ثمة مناطق زراعية متنوعة متباعدة، كاليمن وعمان والبحرين ويثرب ـــ المدينة، والطائف الخ ، وهذه المناطق تفصلها عن بعضها البعض الصحارى الواسعة، وهي لا بد لها من إقامة علاقة تبادل بينها وبين بعضها البعض ومع العالم القريب كذلك.
إن الوقائعَ تشيرُ إلى عمليات تبادل تجارية بين هذه المواقع المختلفة، ويعبرُ التبادلُ عن وجود فائض اقتصادي، تمكنت قوى العمل الشعبية القبائلية من إيجاده، فقام وسطاءٌ هم تجار بإرساله للمناطق الأخرى فاغتنوا واغنوا التجار في المدن، ثم كانت مكة هي الوسيطة الكبرى التي نهضت فوق قوى العمل هذه حتى قوة تجارية عالمية.
كانت هناك مناطق ذات تاريخ قديم في الإنتاج كاليمن، ومن اليمن خرج اليهودُ إلى يثرب وأسسوا فيها الزراعةَ والحرف، كما خرجت قبائلٌ يمينة عديدة إلى يثرب وغيرها من المناطق خاصة شمال الجزيرة العربية، وتعبر قدرات اليهود في يثرب عن تعمق كبير في الجوانب الحرفية.
كانت سلع اليمن هي مثل: النسيج الفاخر، والذهب، والفضة، والأحجار الكريمة، ومواد التجميل، والتوابل بأنواعه ، والأسلحة وغيرها.
إن هذه السلع تدل على تجذر قوى العمل ومهاراتها المتنوعة، وإذ تشير إلى صلات تجارية بالخارج كالهند وأفريقيا، إلا أنها بضائع ومواد خام مستوردة تقوم قوة العمل اليمنية بإعادة تشكيلها ومن ثم تصديرها.
وتعبر مدينة يثرب عن هذا الطابع اليمني الحرفي المتأصل:
«أسس اليهود يثرب وعملوا الزراعة والحرف وصناعة السلاح والحدادة والدباغة والنجارة والصرافة وكان العرب يملكون 13 أطماً واليهود خمسين، وكان في المدينة أكثر من 300 صائغ حلي وكلهم من اليهود العرب وثمة حي اسمه حي الصاغة،» المال والهلال ، شاكر النابلسي ،ص 132.
وكانت المناطق الجزيرية الكبرى الأخرى كعمان والبحرين أقل من اليمن في التطور الحرفي بسبب التكون الحضري البعيد لليمن ومركزية حكمها، وعمان والبحرين تنتجان الموادَ الزراعية غالباً، مع ما يتبع هذه المواد من حرف.
إن هذا التكون التبادلي بين مناطق الجزيرة العربية كان يتبع الطريق التجارية الدولية أساساً، فهو يضخُ ما يزيد عن حاجتهِ إلى الأسواق الخارجية، فأغلب السلع الاستهلاكية الضرورية كالمواد الغذائية تـُستهلك محلياً، وما يزيد عنها وما يُخصص للبيع والتجارة يتوجه للأسواق المحلية ومن ثم المناطقية، وهي أسواق ثلاث كبيرة هي «عكاظ ومجنة وذو المجاز».
وتوضحُ طبيعة السلع اليمنية المُصَّدرة غلبة السلع الاستهلاكية البذخية، التي تباع لمركز التصدير ومن ثم تباع خارجياً، في حين يعيش أغلبية المنتجين على السلع الضرورية.
وبحكم تحول مكة إلى المركزين التجاري والديني معاً، فقد اختلطت السلعُ بالقيم الدينية. كانت المناطق الجزيرية العربية التي تقيم التبادل بينها بحاجة إلى سوق موحد تجري فيه أكبر عمليات التبادل، فكانت مكة التي تحولت من قرية إلى مدينة بفعل الخط التجاري الدولي المار بها، ومن ثم غدت المركز التصديري الرئيسي، فكان المنتجون لكي يستمروا في عيشهم بحاجة إلى تصدير الفائض نحو قبلة مكة التجارية، التي راحت تصير قبلة دينية كذلك ، بحكم إن الشعائرَ الدينية تحمي السلع والنقود الناتجة منها والعمليتان متداخلتان.
لكن المنتجين لم يفعلوا ذلك مباشرة، بل من خلال الوسطاء التجاريين، الذين كانوا يأخذون تلك السلع ويبيعونها، وفي البدء نيابةً عنهم بحكم النشؤ القبلي، ثم مع استمرار التمايز بين المنتجين والمالكين، انفصلوا وصاروا تجاراً مستقلين.
وتبينُ نشأةُ مدينة مكة هذا النموَ المتمايزَ للفئات التجارية من قلب العلاقات القبلية، ففي البداية نجد أن جد القبيلة «قصي بن كلاب» عنده أغلب وظائفها الدينية والتجارية مما عبر عن وحدة قبلية كلية في القمة، ثم تنشأ البيوتاتُ التجارية العائلية؛ كأمية وبني مخزوم وبني هاشم الخ .. مثلما تظهر العائلات الغنية والعائلات الفقيرة.
لكن الفارقَ بين مكة وبقية المناطق إنها غير منتجة لسلعٍ، بل هي تستقبلُ السلعَ وتصدرها، وتحتفظ بجزءٍ ضئيلٍ منها للاستهلاك، فهي بلا جذور حرفية وبلا زراعة، ومن هنا قامتْ بتحويل جزء من رؤوس أموالها لتملك الأراضي في المناطق المجاورة فكانت «الطائف» بستانها، و«جدة» ميناءها فغدت دويلة اقتصادية.
تعبرُ مكة عن المدينة التجارية الخالصة، التي لم تتطور من داخلها لتكون مدينة تجارة، بل هي قد أسستها الضرورة التبادلية العالمية والمناطقية، ولهذا فإن المناطق الأخرى لم تستطع أن تتطور مثل مكة في نموها الاقتصادي وفي عقليتها التحديثية.
لقد ساعدها غيابُ الجذور الزراعية والحرفية لكي تكونَ مدينةَ مالٍ وسلعٍ بالدرجة الأولى.
لكنها مع ذلك بحكم خلفيتها الدينية التي رُكبت وتصاعدت بفضل دورها التجاري التوحيدي، فكان هذا الدور يعضد المكانة التجارية ويضفي عليها قداسة، ولكن هي قداسة تجميعية للرموز الدينية مثلما هي تجميع للسلع التجارية.
ومع ضخامة دور الوسيط بين المنتجين المتوارين، سواء كانوا عرباً أم أجانب، فإن الوسيطَ هو الذي أثرى أكثر من أولئك المنتجين، وتدلنا الأرقامُ التجارية للسلع ولأرباحها عن ضخامة الرأسمال البضائعي الذي يتدفق والذي يتحول من جديد للتجارة، أو يشتري الأرض العقارية، التي كانت محدودة بحكم ضخامة الصحراء.
ومنذ البداية نلمح هذا التناقض الهام بين كمية النقد الكثيرة المتوفرة وغياب التوظيفات الفاعلة، فيذهب قسمٌ كبير من النقد نحو الاستهلاك البذخي، فيضيع من دورة رأس المال، ولكنه في هذه المرحلة لا يضيع بل يوظف لكن حين ستنشأ أسرٌ حاكمة ويتراكم الفائضُ لديها فسوف يتجه إلى البذخ الخالص.
كان في جزيرة العرب طريقان للتجارة «أحدهما شرقي يصل عمان بالعراق وينقل بضائع اليمن والهند وفارس براً، ثم يجوز غرب العراق إلى البادية حتى ينتهي به المطاف في أسواق الشام» «والطريق الثاني هو الأهم وهو غربي يصل اليمن بالشام مجتازاً بلاد اليمن والشام ناقلاً أيضاً بضائع اليمن والحبشة والهند إلى الشام وبضائع الشام إلى اليمن حيث تصدر إلى الحبشة والهند عن طريق البحر»، كتاب أسواق العرب، ص9 .
من المدن التجارية الهامة في العصر القديم «تيماء: المحطة الكبرى العامة شمالي الحجاز مروراً بسلع وبُصرى وتدمر ودمشق».
«كان للعرب دراية بالملاحة منذ القرن العاشر قبل الميلاد»، «عن تاريخ العرب الأدبي نيكلسون» ويضيف: «وكانت صعوبة الملاحة في البحر الأحمر تجعلهم يفضلون الطريق البري».
«كانت القوافل تقوم من شبوت في حضرموت وتذهب إلى مأرب عاصمة سبأ ثم تتجه شمالاً إلى مكربة «مكة» وتظل في طريقها من بترا حتى غزة».
«كان الحميريون هم المسيطرون على التجارة جاعلين العرب الحجازيين عمالاً عندهم حتى قبيل البعثة» السابق ص 11.
«منذ القرن السادس انتقلت التجارة تدريجياً من اليمنيين إلى قريش».
قال الألوسي:
«وأما أهل اليمن وعمان والبحرين وهجر فكانت تجاراتهم كثيرة ومعايشهم وافرة لما في بلادهم من الخصب والذخائر المتنوعة والمعادن الجيدة»، ص 11 «على أن لــ طيئ ومنازلها أواسط نجد شهرة في الاتجار شمالي جزيرة العرب».
(وقدّر بعضُهم ما يشتريه العالمُ الروماني من طيوبِ بلاد العرب والفرس والصين بقيمة مائة مليون من الدراهم) ص 12.
وتعبيراً عن التبادل المناطقي الواسع قالوا: (برود اليمن وريط الشام وأردية مصر). ومن أقوالهم: (الطائف مدينة جاهلية قديمة وهي بلد الدباغ يدبغ بها الأهب الطائفية المعروفة). أما (هجر والبحرين فهي متجر التمر الجيد).
كان التجار يُسمون السماسرة فجاء الإسلامُ بكلمةِ معشر التجار. وهناك اسماء أعجمية وَرَدتْ للعرب تحملُ أسماءَ البضائع: (الصنج والصولجان والفيل والجاموس والمسك وخصوصاً أنواع النسائج كالديباج والاستبرق والابرسيم والطيلسان) السابق ص 18.
وتعرفنا بعض الكلمات الأعجمية التي عربت وصارت جزءً من التسميات العربية على تغلغل العلاقات البضائعية في الحياة الجاهلية مثل:(ترف وجزية ودرهم وفندق وقارب ولص). سردَ هذه الكلمات بندلي جوزي في بحثه (بعض إصطلاحات يونانية في اللغة العربية) في مجلة مجمع اللغة العربية 3 / 330 نقلاً عن المصدر السابق، ص 19).
قال معاوية لصوحان صف لي الناس فقال: خلق الناس أخيافاً، فطائفة للعبادة، وطائفة للتجارة، وطائفة خطباء، وطائفة للبأس والنجدة، ورجرجة بين ذلك يكدرون الماء ويغلون السعر ويضيقون الطريق.
وقد عرف العربُ سندَ الملكية (طابو) والعقود.
ومن كتاب المحاسن والأضداد نقرأ ( إن العديد من رؤوساء قريش كانوا باعة وحرفيين). وتعددت البيوع عندهم مثل: بيع الغرر، أي بيع ثمر النخل والشجر لمدة عام أو عامين وهو مرفوض دينياً.
بيع التصرية وهو عدم حلب الناقة لفترة من أجل أن تمتلئ وهو شكل من التحايل.
البيع الناجز وهو البيع الصحيح يداً بيد.
(في البدء كانوا يتعاملون بالمقايضة ثم تعاملوا بنقود الروم والفرس، الدنانير والدراهم، ويقدر الدينار بعشرة دراهم، والدرهم يساوي عشرة قروش مصرية (حسب زمن المصدر 1960)
ويدل هذا على ضعف تطور العلاقات البضاعية ــ النقدية، ثم نموها عبر تنامي إنتاج القبائل عبر مئات السنين، واستمرار سيطرة الفرس والروم السياسية، فكان فائضٌ ما ينتقل من الجزيرة للأمبراطوريتين، ثم غدت نقودهما نقودَ الأمبراطورية الإسلامية التي وورثت الهيكل الاقتصادي ــ السياسي العبودي ــ الإقطاعي دون أن يستطيعَ التراكمُ المالي أن يؤدي إلى المرحلة الرأسمالية.
وجاء لدى المقريزي إن أول من ضرب السكة عمر بن الخطاب على نقود فارسية مع كلمات عربية إسلامية.
وكان لديهم (المكس) وهو أخذ العشر من بائعي السوق والمكس في اللغة النقص وفي البيع انتقاص الثمن. قال الشاعر:
أفي كل أسواق العراق أتاوة/وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم
وحول الاستغلال وتراكم الأموال، جاء في خزانة الأدب (كان أحيحة بن الجلاح كثير المال شحيحاً عليه يبيع بيع الربا في المدينة).
عُرف بعض الصحابة باستخدام الربا كخالد بن الوليد وعثمان بن عفان وحين جاء الإسلام تركا الربا بطبيعة الحال، وكان الرهن يصل إلى رهن البشر مما يعبر عن كوابح تطور العلاقات البضائعية النقدية وانغمارها بعلاقات العبودية وقتذاك.
وهناك ربا الأضعاف المذموم بشدة في القرآن ((لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة)) آل عمران 3، وهو أمرٌ يعبرُ عن هدف سياسي هو زعزعة سيطرة القبائل اليهودية على المدينة وعلى العرب وقد أخذ الفقهاءُ هذا الحكم كحكمٍ مطلق وليس نسبياً، ثم جاء فقهاءٌ حاولوا تجاوز هذه الإشكالية عبر ما ُسمي بفقه (الحيل). وهذا كله يبين استمرارية تنامي العلاقات البضائعية النقدية لدى العرب رغم الكوابح الطبيعية الهائلة والشظف والتحكم السياسي الجائر في عصور الدول الاستبدادية.
لم تستطع العلاقات المالية والبضاعية كشكلٍ أولي من العلاقات الرأسمالية أن تحصل على مساحة أساسية في البناء الاجتماعي العربي الجاهلي، بسبب ضخامة العلاقات الأبوية التي تتمظهرُ في سيطرة شيوخ القبائل على أجسام القبائل في حركاتها الانتقالية المكانية وفي توجههاتها، عبر الحفاظ على البناء الاجتماعي التقليدي القائم على خضوع الفقراء للأغنياء والصغار للكبار والنساء للرجال والعبيد للسادة.
وهذا كله يؤدي لعدم ظهور وتراكم الرأسمال.
وتلك سيطرة اجتماعية موجودة في كل القبائل، لكن لم يكن لرؤساء القبائل مركز سياسي ما، فجاءتْ الدولةُ العربية الإسلامية لتضعَ الأسسَ لانتقال سيطرتهم الاجتماعية لتكون سيطرة سياسية بعد هزيمة دولة الجمهورية الشعبية زمن الخلفاء الراشدين.
وتلك السيطرة الاجتماعية على كل قبيلة منفردة، توحدت بالنظام السياسي الأمبراطوري، الذي كرسَّ سيطرة زعماء القبائل، وأشركهم في المداخيل واستعان بهم في الجيوش والحروب الخ..
وبهذا فإن العلاقات المالية البضاعية في زمن الجاهلية لم تحصل على بنية اجتماعية مُستوعِبة لها، بسبب ضخامة الصحارى وتشتت القبائل والمدن.
فبقيت العلاقاتُ الرأسماليةُ الجنينية على ضفاف العلاقات الاجتماعية الأبوية وحين تكونت المدنُ الإسلامية الأولى خاصةً، كالبصرة والكوفة والفسطاط والقيروان وفاس فإنها كانت معسكراتٍ للجيوش، مما جعلها مراكزَ سياسية بدرجة أولى، ثم تحول بعضُها إلى مدنٍ تجارية كبيرة لأسباب خاصة بها كالبصرة التي غدت الميناء الكبير على ضفة الخليج.
أما السيطرة الاقتصادية الكبرى على الثروة والإنتاج فكانت من نصيب نفس تكوين الشيوخ القبليين في زمن الجزيرة الجاهلية، ولكن صارت سيطرتهم مركزةً في أسرة واحدة وفي شخص الخليفة، وغدت الأملاكُ الكبرى الزراعية هي الأساس الاقتصادي للدولة، ومن الخراج و مكوس التجارة تتشكل أغلبية الدخول.
تغدو الملكية الزراعية الإقطاعية هي ملكية عقارية غير داخلة في التداول البضائعي بشكل عام، لأنها بعضها يُوهب أو يُباع، ولكونها هي مصدر أغلبية الثروة الأساسية فإن (المجتمع) يكون قد أعاق نمو العلاقات البضائعية بطريقة سياسية مخربة على المدى الطويل.
إن الملكية العقارية الكبرى هي بضاعة في ذاتها لكنها مملوكة للإدارة السياسية فتتجمد وتعرقلُ تطورَ السلع ونموَ رأس المال، وهي كذلك وسيلة من وسائل إنتاج البضائع، عبر تحول مداخيلها عند الأسرة الحاكمة وأسر الكبار عموماً إلى وسيلة اكتناز وبذخ، فتغدو مصدراً لحراك اقتصادي يؤدي مع مرور السنين إلى الأفلاس، لأن المداخيل (أو الجزء الأكبر منها) لا تعود لبنية الإنتاج.
إن الطبقات والفئات التي تستولي على النصيب الأكبر من الفائض الاقتصادي تدرجهُ في الاستهلاك الشخصي، فسواءٌ كان ذلك لدى الخلفاء وزوجاتهم وابنائهم أم لدى التجار الكبار والقواد وكبار رجال الدين الحكوميين، فإن الفائض لا يعود مرة أخرى لتطوير الإنتاج إلا بنسبة ضئيلة كترميم السدود.
وسنجد بعض مظاهر تدهور رأس المال التجاري كالهجوم على أموال كبار التجار وقيام هؤلاء بإخفائها تحت الأرض، والسطو على أموال الخلفاء أنفسهم وسرقة مصاغ زوجاتهم، في حين إن الوضع الاقتصادي العام يشير إلى الخروج المستمر للذهب من الديار الإسلامية، وتدهور قيمة العملتين الذهبية والفضية، وتدني وتدهور الحاصلات الزراعية، وجمود الحرف بسبب عدم تغلغل الرأسمال المادي والعلمي بها، فتغدو الحرف عاجزة عن التحول للصناعة، بل تصيرُ مهناً تقليدية يسيطر عليها أسطوات ومعلمون يحولون طرق الإنتاج فيها إلى أسرار، ويحولون الشغيلة إلى تلاميذ. وهذا ما يكون مناسباً في مستوى الثقافة مع الثقافة الصوفية التي تغدو هنا طرق دراويش مخلوطة بسحر وخزعبلات.
هكذا فإن رأس المال يغدو على ضفاف المجتمع الإسلامي، سواء بتدميره على مستوى الطبقة الحاكمة بالبذخ، أو على مستوى الشغيلة بتحجر الإنتاج وتدهوره المستمر.
ولكن بين التوسع الكبير للإنتاج الزراعي وضخه للموارد في المدن وبين انهياره ثمة قرون من التطور الاقتصادي الذي تظهر فيه إبداعات اجتماعية وثقافية كثيرة.
ونستطيع أن نرى تبايناً في علاقات الإنتاج والتداول، فثمة علاقات عبودية جزئية وإقطاع سياسي متحكم بشكل عام، وعلاقات رأسمالية غير سائدة تتمركز في التجارة خاصة.
وإذا حدث تناغمٌ بين الإقطاع السياسي والعلاقات الرأسمالية، بمعنى عدم قيام الإقطاع الحاكم بتضييع الثروة وساهم بفتح المجال لنمو التجارة والحرف، أي بتطوير مصادر الإنتاج، فإن العهدَ يشهد ازدهاراً، كما حدث في بعض فترات الحكم الأموي أيام معاوية وعبدالملك بن مروان، ثم في الدولة العباسية لدى المنصور وهارون الرشيد والمأمون، ولكن مع تفاقم نفقات الحكم والجيش فإن ذلك يؤدي لتدهور مصادر الإنتاج، وقيام فترة الاضطرابات و مجيء الحكام الضعاف وتدهور الثقافة الخ، كما نلحظ ذلك مع حكم المعتصم العسكري البذخي ثم تنامي التدهور في الخلفاء من بعده، وتؤدي الحروب دور المعجل للتفسخ والتجزؤ للأمبراطورية.
وعلى الرغم من السيطرة العامة لنظام الإقطاع على النظام الاجتماعي الإسلامي إلا أن هذا النظام شهد نمواً كبيراً للرأسمال التجاري لا يصل بطبيعة الظروف السابق شرحها إلى تجاوز ذلك النظام.
وقد أوضحنا كيف إن هذه العلاقات التجارية والمالية ازدهرت بشكل واسع، وعرفت كل أشكال التبادل التجاري والمالي، بين المناطق العربية الإسلامية وبينها وبين العالم.
وإذا كانت هذه العلاقات لم تصل إلى إزاحة البناء الاقطاعي، أي هيمنة الأسر على المال العام والإنتاج، فإنها نقلتْ جوانبَها المتقدمة إلى القارة التي سوف تتفتح فيها هذه العلاقات التجارية المالية على أوسع مدى وهي القارة الأوربية.
وبعكس الآراء الزاعمة بقيام العرب بخلق التخلف الأوربي فإن المعطيات التاريخية الموضوعية تشير إلى العكس أي قيامهم بخلق أسس النهضة على مستويي الاقتصاد والثقافة.
وهكذا فإن درجات التطور الرأسمالي العالمي لها حلقات مشتركة من الأدنى إلى الأعلى وبالعكس، فبعد التدهور الاقتصادي الذي جرى في أوربا خلال القرنين السابع والثامن الميلاديين، ظهرت الدويلات الإقطاعية الصغيرة وصارت الكنيسة الكاثوليكية أكبر مالك للأرض الزراعية وتحكمت الجيوش والأنفاق الهائل عليها مما زاد من الضرائب التي أضعفت الإنتاج.
ووقع الاحتكاك العربي الأوربي الاقتصادي الإيجابي في حوض البحر الأبيض المتوسط، ومن هنا نرى أن المناطق الداخلية والغربية الأوربية عرفت النهضة لاحقاً، وتركزت النهضة في المدن الإيطالية القريبة من الممالك العربية، ورغم إن الرأسمال التجاري الإيطالي تشابك بقوة مع الحملات الصليبية التي استثمرها إلا أنه تنامى أكثر بفضل نمو التجارة السلمية، فسك العملات النقدية الجديدة وأسس الشركات، وغيّر نظامَ الأرقام مدخلاً نظامَ الأرقام العربية وترجم ونقل الكثير من جوانب العلوم الطبيعية والرياضية والفلسفية العربية، وكل هذه الخميرة انتقلت إلى الدول الأوربية في الوسط ثم في الشمال والغرب، والأخيرة هي التي قامت بالثورة الصناعية والرأسمالية الشاملة بفضل ابتعادها عن مركز الإقطاع في روما وازدهارها بالتجارة والاكتشافات الجغرافية.
بطبيعة الحال فإن قانونَ النمو داخليُّ دائماً لكن المؤثرات الخارجية الإيجابية تسرعُ من الصراعات الداخلية باتجاه التقدم، ولم يستطع الرأسمال الصناعي الظهور في غرب أوربا إلا بتراكمات هائلة أوربية وعالمية، حيث عملت التدفقات النقدية والمعلومات العلمية وحرية بعض المدن على هدم الجدار الكبير بين الحرف والصناعة، أي عبر خلق نظام المحركات في إنتاج السلع: (المانيفكتورة ثم المعامل). وهو أمرٌ عجز عنه العرب للأسباب السابقة الذكر. وبهذا التحول تم ظهور نظام الرأسمالية العالمية ومنشأه أوربا الغربية.
إن وجود مناطق حرة لظهور الرأسمال الصناعي، حرة من حيث عدم تسلط الحكومات ورجال الدين المحافظين، قد تشكل في المناطق البعيدة عن المركزيات المتشددة، وعبر خلق سوق قومية الخ..
ولكن مع تحول الرأسمالي الأوربي القاري – العالمي، فإن السيطرة على المواد الخام والأسواق الخارجية صارت معرقلةً لنمو الرأسماليات في الدول المتخلفة، فقام الغربُ بالتحكم في أسواق الدول العربية والإسلامية، مانعاً إياها من العملية التي ساهمتْ هي فيها وأسست تقدمه، أي أنها كونت مرحلة الرأسمال التجاري التأسيسية، فوضع الغربُ الأمبريالي اثناء سيطرته الأولى القيودَ الكثيرة على بقاء الدول العربية والمختلفة عامة في مرحلة الرأسمال التجاري دون المساح لها بالصعود إلى مرحلة الرأسمال الصناعي. فعاش الشكل الأعلى وهو الرأسمال الصناعي (الحر) أكثر من قرن على التحجيم والقيود.
فحين جاء الاستعمار الغربي لم يعمل على تغيير البناء الإقطاعي الموروث بل حافظ عليه ووطده. بأن جعل الحكام يحصلون على قسم كبير من الثروة من خلال التحكم في أجهزة الدول، وهو الأمر الذي حافظ على البناء الإقطاعي القديم، بكل بنيته الاجتماعية، وكان الحكام هم الغربيون ثم سلموا الحكم للقوى المحلية التي جُيرت لخدمة البناء الاقتصادي التابع.
وهذه العملية الاقتصادية العالمية المتضادة، أي دفع العرب أوربا للتقدم ثم دفعُ الغربِ العربَ للتخلف، تعكس طبيعة النظامين العالميين الإقطاع والرأسمالية، في مرحلة النشأة الأولى العالمية للنظام الحديث، وهي تعكس مستوى قوى الإنتاج على الجانبين، فالنظام الأول العربي يقومُ اقتصادياً على الخراج والمكوس والغزو (وهو شكل من الاستيلاء المباشر على السلع)، في حين يقوم النظام الثاني الغربي على تصدير رأس المال والسيطرة على الأسواق. فكان من الطبيعي أن يحدث تصادمٌ كبيرٌ ومأزقُ بين التشكيلات الاقتصادية البشرية الكبرى.
وهذه المرحلةُ من العلاقة بين الإقطاع الشرقي والرأسمالية الغربية هي مرحلة أولى لأن مراحل أخرى ستتشكل تبعاً لتبدل قوى الإنتاج الغربية وتطور الدول الشرقية كذلك، فتغدو التشكيلة الرأسمالية عالمية تزيل التشكيلات التي كانت قبلها بشكلٍ تدريجي.
لقد ابقت الرأسماليةُ الغربية الدولَ العربية في البناء الإقطاعي و(تطوراته) ويظهر ذلك في الحفاظ على طبيعة الحكم السياسي الذي يغدو مالكاً لقسم كبير من الثروة عبر الجهاز الحكومي، وهو الجاب الذي يمثل استمرارية للدول السابقة الأموية والعباسية والطوائف، فهنا لم يحدث قطع بنيوي، ولم تجعل الدول الغربية السيطرة الدول العربية على نموذجها بل أبقتها في الماضي، في ذات التشكيلة الإقطاعية، فصارت التطورات المالية والتجارية القديمة والمحدثة تجري في البناء القديم لأسباب سياسية واقتصادية عميقة.
يتحدد تاريخ البشرية في القرن العشرين بصراع الرأسماليات الغربية الكبرى القوية برأسماليات الشرق النامية الضعيفة، وقد قُيض لرأسماليات الشرق أن تبرز روسيا كقوة طليعية عالمية لها، وبطبيعة الحال وبسبب مستوى الوعي، أُعتبر ذلك صراعاً بين الرأسمالية والاشتراكية، وأعطى الشكلُ الذي ظهرتْ بهِ الرأسماليةَ في روسيا كشكلٍ رأسمالي حكومي التباساً في فهم العملية التاريخية، لكن كان ذلك إبرازاً لسببية أقوى هو دور الدولة في الشرق الحاسم في عمليات التحول الاقتصادية.
لقد كان بروز الدولة في هذه العملية التاريخية إستعادةً لهذا الدور القديم الراسخ، ولكن جرى هذه المرة في سبيل إحداث قفزة اقتصادية كبرى، أدت إلى خلق القواعد الرأسمالية الحقيقية للاقتصاد عبر التركيز على الصناعة الثقيلة المحورية في حدوث الانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية، مع يترافقها من عمليات تحديث اجتماعي وثورة ثقافية ومساواة قانونية للنساء بالرجال، وبالتالي قربت هذه العملية التاريخية الكبرى روسيا من مصاف الدول الرأسمالية الكبرى في غضون نصف قرن، إذا تغاضينا عن الحروب التي شُنت على روسيا والمقاطعة الاقتصادية والعلمية، وكان لذلك ثمن باهظ لكن العملية أُنجزت، كما قامت روسيا كذلك بجعل تجربتها عالمية عبر الصين وفيتنام وأوربا الشرقية الخ..
ثم انضمت دولٌ عربيةٌ إلى هذه التجربة بدون ذلك الحسم السياسي، وهو قوة الدولة في تغيير الهياكل الإقطاعية وإحداث القفزة الكبرى بسحب الفائض الاقتصادي من مسام المجتمع كله وتوجيهه نحو الصناعات الكبيرة والعلوم.
وإذ استطاعت دول روسيا والصين وشرق أوربا من تحقيق معدلات تنمية غير مسبوقة بشرياً، فإن دول العالم الثالث الأخرى ظلت تراوح في مشكلاتها وتخلفها وتجرجر أذيال الماضي كامعاء لا تـُدفن، لكن ذلك لا يعني عدم حدوث أخطاء كبيرة في التنمية.
فقد عملت التجربة على تملك كل أشكال الملكية الخاصة دون تفريق ونظرة بعيدة المدى، فصادرت الأملاك الإقطاعية الأسرية والدينية أولاً، ثم الملكيات الصناعية والتجارية ثم توجهت لأملاك الأرض المتوسطين ومن ثم الصغار، مما حول الدولة إلى المالك الوحيد، باعتبار أنها ستكون جسراً نحو الملكية الشيوعية المفترضة، أي أن هذه الملكية العامة ستلغي نفسها، وهو عكس التصور الشيوعي الأصلي الذي يقول بأن الملكيات العامة الناتجة من تطور تقني هائل، لن تحتاج إلى دولة لتشكلها بل أن الدولة نفسها ستذوب وتغدو إدارة الاقتصاد ذاتية من قبل المنتجين وإداراتهم، فيغدو التصور (الإشتراكي) الروسي مطابقاً لرأسمالية قومية، تقوم بتضخيم الدولة وتسريع العملية الاقتصادية، وهو ما قلنا بأنه يتماشى مع الجذور الاستبدادية الشرقية في عملقة الدول وتحكمها، وهذا ما أدى إلى قدرة هائلة على السيطرة على الفوائض الاقتصادية وتوجيهها إلى الصناعة الثقيلة، وعبر تقشف وزهد ثوري خاصة في البداية، وتوسيع المشاركة الشعبية والحزبية إلى اقصى حد في التنمية ومراقبتها، وبدون هذا التلاحم الشعبي والحزبي والقتالية الثورية التي تشكلت خلال هذا الوهم الإيديولوجي بتشكيل الاشتراكية وإذابة الفروق إلى الأبد بين الأغنياء والفقراء، وعدم العودة للاستغلال، ما كان للتضحيات الشعبية أن تتشكل.
ولكن حدثت المعجزة بشكل آخر وهو انضمام الدول الشرقية الكبرى إلى النادي الرأسمالي الغربي، في حين أن الدول العربية التي ماشت هذا الوهم الإيديولوجي ماشته بكثير من التردد والخوف، فقد عارضت مصادرة الملكية الإقطاعية السياسية والدينية، رغم أنها هي الأخرى كانت تعبيراً عن دكتاتورية شعبية لكن هذه الدكتاتورية لم تلبس ملابس الدكتاتورية الطبقية المفترضة، فهي خائفة من دهسها من قبل هذه الدكتاتورية، وهكذا كان قادة المعسكر (الاشتراكي) قادمين من صفوف العمل السري الطويل ومن الحروب الأهلية ومن بين العمال والفلاحين، لكن قادة (الاشتراكية) العربية كانوا عسكريين بيروقراطيين، فعجزوا عن الحسم مع الملكيات الإقطاعية والإرث الإقطاعي الاجتماعي والديني، فوجهوا ضرباتهم الاقتصادية إلى البرجوازية الصناعية أولاً، في حين تركوا الوسطاء من مقاولين ومن صيارفة ومن ملكيات زراعية كبيرة، وتركوا القوى العمالية الفائضة دون حشدها في قوة العمل الاجتماعية، فاستمرت قوى الهامشيين كالعاطلين واللصوص والشحاذين والمومسات بشكل واسع، وعجزوا عن دمج أكبر قوة مهمشة في الإنتاج الاجتماعي وهي النساء، وكان من ثمار هذه السياسة (الإشتراكية) عدم بناء الصناعة الثقيلة فاستمرت نفس الهياكل الاقتصادية المتخلفة مع بعض التطور في الصناعة المتمثل في بناء بعض مصانع الحديد والصلب وغيرها من المنشآت كمنشآت الري، هي الحدود التي بلغتها مثل هذه التنمية التي رفضت تشكيل الصناعة الثقيلة، بدعوى عدم التضحية بالجيل الراهن، وما لبثت أن تنامت سوسة البيروقراطية والفساد في هذه الملكية العامة نفسها، فقلصت إيجابياتها أو جعلتها في خدمة قوى الطفيلية المتصاعدة.
وفي حين أن الدول الشرقية (الاشتراكية) قد عانت فيها الصناعة الخفيفة المهلة، وأدت البيروقراطية إلى شلل تقني وإلى العجز عن ملاحقة الثورة المعلوماتية والعلمية، بعكس ما كانت تنادي به الاشتراكية في أدبياتها الأولى، لكن الصناعة الثقيلة قد شكلت، وتغلبت في أحيان عديدة على مستويات بعض الدول الرأسمالية الغربية. أما الدول الاشتراكية العربية فهي ضيعت الصناعتين فلم تجذر صناعة ثقيلة ولا خفيفة، وكان من جراء ذلك ما سُمي بــ(الانفتاح) وهو القضاء على الصناعتين معاً وترك الاستيراد يستولي على السوق الوطنية.
ودليل ذلك يظهر في السلعة، حيث لا توجد سلعة مصنعة عربية هامة، في حين إن الدول الشرقية (الاشتراكية) تمكنت من تصنيع سلع كبيرة رغم أن المواصفات ليس بجودة السلع الغربية تماماً، لكنها في الطريق لكسب معركة الجودة والنوعية.
وهذا يعني أن الطبقة الإدارية التي لبست عباءة الاشتراكية في الشرق إعادت تشكيل قوة العمل البشرية لتلائم الاقتصاد الحديث، وحافظت على خلق سوق وطنية كبيرة محمية، ووجهت الفوائض الاقتصادية نحو معركة التغيير الاقتصادي الحاسم، وغيرت البنية الاجتماعية الشعبية المحافظة التقليدية لتلائم سوق العمل العصري في حين لم تفلح ذات الشريحة في العالم العربي القيام بذلك.
يقوم المضمون الإقطاعي العربي الموغلُ في القدم بدمغ أية ظاهرة واردة من الخارج، فيحيلها إلى هيكليتهِ ويمتصُ حداثتَها في تخلفه، ورأسامليتها في إقطاعيته.
فامتيازاتُ النفط وواردته تقسم بين الشركة الغربية والعائلة الحاكمة أو قيادة الحزب أو قيادة الدولة، فبدلاً من أن تكون ملكية النفط إنتاجية خاصة أو تابعة لدولة ديمقراطية، تصبحُ ملكاً لأطراف سياسية متنفذة، تعكس مصالح الطبقة المسيطرة في البلد المعني.
وفي حين يخصص قسمٌ صغيرٌ للخدمات ومصالح الدولة العامة تقوم ذات القوى المحلية المهيمنة وحلفائها في الإدارة بشفط قسمٍ آخر منه ذلك التقسيم الثنائي؛ غربٌ مستكشفٌ مستورد، وشرقٌ منتجٌ مالك، وهي تسمياتٌ على غير مسمى.
هكذا يقوم الإقطاع بتحويل ملكيةٍ رأسمالية حديثة إلى ملكية إقطاعية أساسية، في موارد الإنتاج الكبرى، ثم تجري كل العمليات الاقتصادية الفوقية بطريقة رأسمالية من تحديد للرأسمال الثابت أو المتغير وأسعار المواد الخام وبيعها، ولكن المضمون الأساسي، وتحديد أساسيات الدخل، تتم من خلال عوامل سياسية مسيطرة على العلاقات الاقتصادية، وهو أمر لا يختلف عما حدث في العصرين الأموي والعباسي.
وهذا يندرج على الاصطفافات التجارية وطبيعة العائلات التجارية التي تتشكل من خلال قرارات سياسية عليا، عبر تشكل علاقات سياسية معينة بين الطبقة المسيطرة وهذه العائلات التجارية، فيجري السماح لعائلات معينة أو منع عائلات معينة من التجارة أو من الدخول إلى البلد، أو إعطاء جنسيات معينة حق مزاولة مهن مهمة، كما حدث للعائلات الأوربية المهاجرة في بعض الأقطار العربية ومنحها أمتيازات لا تـُمنح لمهاجرين آخرين.
وتقوم العائلة المالكة للأرض والعباد أو المكتب السياسي للحزب الحاكم أو هيئة الضباط المتنفذة، بتقريب أو إبعاد الموظفين الكبار وتحديد بناء الوزارات والإدارات تبعاً لمصالحها ونفوذها ومداخيلها.
بل حتى الموظفين الصغار يتأثرون بالسيطرة الإقطاعية على أجهزة الدولة، فهي ترتبُ الدوائرَ لخلق صراعات مذهبية أو دينية أو قومية وتكون خالية من الأفكار المناوئة لها، وتخفض الرواتب هنا من أجل ضبط السيطرة وخلق الفئات الدنيا المحتاجة.
وإذا كان المضمون الإقطاعي هو المشكل لجوهر الملكية العامة فالطلاء الغربي الخارجي يكون متحداً بذلك المضمون، عبر المظاهر الحديثة والأشكال المحاسبية الغربية، لأن السلعة الخام لن تبقى في البلد المعني، بل سوف تكون من نصيب البلد الغربي، فليس مكان الإنتاج سوى مكان عابر، في حين يكون البلد الغربي الرأسمالي هو المكيف للسلعة من أجل حاجته ومشروعاته وتطوره. فيغدو البلد (المستورد) هو المنتج، ويصير المشتري هو المتحكم في عملية البيع.
يغدو مكانُ إنتاج السلعة ضمن النظام الإقطاعي المحلي مستهدِفاً لغاياتٍ سياسية بارزة، أهمها استمرار تدفق المادة الخام الثمينة، كمادةٍ خام أو كمادة محوَّلة بعض التحويل، في حين تبقى العمليات التقنية والاقتصادية العميقة من اختصاص البلد المستورد، وهذه التحولات العميقة هي التي تبقي البلدُ المتطور مسيطراً ورأسمالياً في حين تبقى البلدُ المصدرُ إقطاعيةً تابعة.
وإذا حدثت تطوراتٌ رأسمالية في البلد المصدر فإنها تبقى رأسمالية فوقية أو سطحية لا تصل إلى تصنيع المادة الخام إلى اقصى مدى.
وليست المادة الخام ثمينةً إلا لظروف اقتصادية تاريخية تتعلق بأهميتها في بلد الاستيراد المُسيطر، وليس في البلد المُصدر، فمن اكتشفها أو زرعها وخلق شبكة إنتاجها المحلية وشبكة توزيعها الدولية هو البلدُ المستورد، لظروف اقتصادية مرحلية تتعلق بتطور قواه المنتجة، ودور السلعة المستوردة البارز في هذا الإنتاج، وحين تُشاع مثل هذه السلعة أو تحل محلها بدائل كالقطن الذي نافسه الحرير والنايلون والقماش العادي، فإن نظام الاستيراد المسيطر يتغير.
ولا تقتصر قوى نظام المستورد المحلي على الطبقة الإقطاعية المالكة أو المشاركة في الملكية، بل على قوى تقدم مساندة مالية وخدماتية وعملية للمشروع، كالمقاولين الذين يستأجرون عمالاً أو يبيعون مواداً مفيدة للمشروع، أو كالتجار الذين يشترون جزءً من المادة الخام أو المكررة ويوظفونها في السوق المحلية أو يصدرونها للسوق القريبة، ولا بد لهؤلاء أن يكونوا مرضيين عنهم من قبل الطبقة المسيطرة، حيث يمثلون جزءً من الحزام الاجتماعي الحامي للمشروع.
أما العمال فهم يجلبون بسبب قوة عملهم، التي يخضع تطورها لتطور قوى الإنتاج في المشروع.
إن السيطرةَ الإقطاعية تصيرُ دائماً هي مضمون الظاهرات الاقتصادية، في حين يغدو الشكلُ رأسمالياً، وهذا التناقضُ هو مشكلُ البضاعةَ الأساسية، التي هي المادة الخام الكبرى التي يقوم عليها الاقتصاد كالفوسفات أو البترول أو القطن، ومن ثم يتغلغلُ في كل ظاهرات الإنتاج والحياة.
فكما رأينا كيف غدت سلعة البترول وهي البضاعة الأساسية التي ستحركُ نظامَ الإنتاج برمتهِ متناقضةً بين سيطرة الإدارة السياسية الاستعمارية – المحلية، ذات التوجه السياسي المفروض من أعلى، وبين طبيعة السلعة ذات المعايير الاقتصادية الحديثة المجلوبة من الغرب والمعبرة عن عالم (حر)، فنرى في (البضاعة) صراع التشكيلتين وتباينهما.
فهنا إقطاع وهناك رأسمالية، هنا قديمٌ مهيمن، وهناك حديثٌ براني خارجي، وكما يبدو ذلك في السلعة التي تشكلُها قوةُ العمل فإن قوةَ العمل ذاتها تعيشُ نفس التناقض.
فقوة العمل المنضمة لأحدث نظام اقتصادي عالمي وقتذاك تكون مُخرجةً من حقولٍ خربة أو كاسدةٍ أو من مغاصاتٍ انتهى زمانها، أو من اقتصاد رعوي ضاق بأهله، أو من ريف متخلف تكنولوجياً واجتماعياً.
ومن هنا فالعاملُ وهو يبيعُ قوةَ عملهِ يبيعُها في وقتِ كساد أو أزمة أو انهيار أو ضعف، ولهذا فإن المعروضَ من قوة العمل يكون كبيراً، فتتدنى الأجورُ إلى أدنى حالاتها، في سلعةٍ هي ثمينة جداً على المستوى العالمي.
فالمجتمع المتخلف التابع لا يعرضُ سلعتيهِ: البترولَ والعمالَ، وهو في حالةِ حرية، بل في حالة تبعية، فيعرضهما بأسعار متدنية، سواءً على المستوى السياسي الذي يظهرُ في امتيازات النفط الممنوحة بشكلٍ أسطوري للشركات الأجنبية، أو في حالة أجور العمال التافهة.
ومن هنا فهو يقدمُ قوةَ العمل وهي في مجتمع تقليدي، مصنوعةً من موادِ عيشهِ البسيطة كالأرز والخبز والأسماك أو العدس والفول، أي كل المواد التي تصنعُ جسمَ العامل بأسعار متدنية جداً.
مثلما أن أماكنَ سكنهِ هي الأكواخُ والبيوتُ الكبيرة المزدحمة بالأطفال، ذات الإيجارات البسيطة، مثلما أن معرفته معدومة وعقله مشحون بالخرافات، وهو يجلبُ للاقتصاد الحديث ما تعلمهُ من عادات في أعمالٍ سابقة أو من فنون تعايشت واقتصاد مختلف، كما يجلبُ خاصةً أميتَهُ التي تكون بعيدةً جداً عن قراءة اتفاقيات النفط أو كيفية تشغيل الآلات.
وهكذا فإن العاملَ القادمَ لاقتصاد عصري يكون قادماً من اقتصاد إقطاعي ينهار، يعرضُ قوةَ عملِهِ كبضاعةٍ تشكلتْ في اقتصاد تقليدي، ومن هنا يتحدثُ هذا العامل شكلانياً، أي يصيرُ جزءً من عالم الحداثة وهو يحملُ داخلَهُ علاقات المجتمع الإقطاعي وثقافته، فيقوم بتغيير الثوب البحري أو الريفي أو البدوي، ويلبس البنطلون، الذي هو زي موحد سواء في مصر أم بريطانيا، مثلما يلبسُ القميصَ أو يضع النظارة، أو يتعلم بعض جوانب المهنة الحديثة.
وحين يرتقى أكثر يعرف بعض أسرار هذه الآلات الجديدة بعض الشيء، من تشغيل وملحقاته.
إن التناقض في البضاعة له مستوياتٌ متعددة، ففي البضاعة ذاتها كجسد مادي خالص، وهي هنا تتبدى كشكل سائل، فإنها تبقى في أرضها الذي ظهرت منه بجسدها نفسه أو بعض مشتقاته، في حين أنها تحصل لها تطورات هائلة حين ما تنتقل للعالم الآخر. ففي الإقطاع تظل مادة تشغيل لبعض المحركات أو مادة ثقيلة للشوارع، أما في الغرب المستورد فإنها تظهر بكل تركيباتها وتتشكل عليها مجموعة كبيرة من الصناعات.
وعلى مستوى آخر فإن هذه المادة حين تتحول إلى رأسمال في البلد المستخرجة منه تتحول إلى مداخيل في اقتصاد إقطاعي، أي تتجه أساساً لخدمة الطبقة الإقطاعية الحاكمة، وإداراتها وجيشها وبوليسها، والجزء الباقي يتوزع بين التجارة وقوة العمل.
أي أن المداخيل في البلد المصدر تتوجه أغلبها لعمليات اجتماعية وسياسية لا تضيفُ تراكماً نقدياً على البضاعة، بل تصبُ في جهة الاستهلاك الجماعي، خاصة مداخيل الطبقة الحاكمة، في حين إن التجارة توظف بعضه لعمليات استيرادية معاكسة لعملية التصدير، والجزء الأخير الأقل شأناً يظهر كأجور.
وفي حين تتضاءلُ رأسماليةُ البضاعة المنتجة في البلد المصدر، وتستحيل إلى علاقات إقطاعية اجتماعية وسياسية وثقافية، فإن كل ينابيع رأسمالية البضاعة تظهر حين تصل البلد المستورد، فتظهر مكونات كثيرة لها، كما تتصاعد قيمها بتحولها إلى مواد مصنعة، فتطور السوق الرأسمالية بقوة.
ويتعاكس التصدير والاستيراد حول البضاعة المركزية، وهي مركزية فقط في حياة البلد المصدر، لكونها مادة خام أولية أو شبه مصنعة تكون أقرب للمواد الزراعية منها للصناعة.
سلعة (البترول) سلعة حديثة رغم عفاريت الكيروسين والقار القديمة التي كانت تتراءى لبدو الصحراء ورغم الجمال المنبوذة التي تـُطلى بها.
فهي سلعة غربية اكتشفها وانتجها الغرب عبر شركاته، فضخم من وجودها ودورها كما يفعل تجاه البضائع العصرية المركزية، كالفوسفات والذهب والفضة وباقي المعادن.
لم يعرف العالمُ القديمُ السلعة المركزية التي تهيمن على البناء الاقتصادي هيمنةً كبيرةً بهذا الشكل، فهو يعيشُ على سلة كبيرة من البضائع، صحيح إن سلعة الذهب كانت تدوخه إلا أنها تبقى أداة نقد واكتناز.
إن تشكيلَ البضاعة المركزية في العالم الشرقي هو في حدِ ذاتهِ عمليةٌ جراحية خطيرة تـُعمل لمريض بالجوع ومصاب بكل الأمراض القديمة، لكنها عملية إعاقة أكثر منها عملية علاج، فهي فقط تشفي الطبيب الغربي من نهمه للذهب. فالبضاعة الرئيسية المركزيةُ تقودُ إلى تورم الجسم، فالمجتمع النفطي يغدو نفطياً، والمجتمع الفوسفاتي يبقى فوسفاتياً، ومجتمع الحرير يبقى حريرياً، ويسيطر الشاي على الهند وسيلان، وتبقى العديد من أقطار أمريكا اللاتينية مصابة باستفحال الموز كبضاعة، وتحاول بريطانيا أن تجعل المجتمع الصيني أفيونياً فلا تقدر وتستطيع أن تجعل المجتمع الأفغاني حشاشاً.
إن الاستعمار يركز على إنتاجِ سلعةٍ واحدة كبرى في البلد المعني، مثلما يقوم في المصنع بتخصيصِ أصبع واحدة للعامل من أجل العمل تاركاً كل جسده الباقي معطلاً، وكما أنه يجعل العامل معاقاً في مصنعه فإنه يجعل شعوباً كثيرة معاقة عن المشي التاريخي الطبيعي.
وفي حين إن بضاعة الشاي الهندية تظهر كجزء طبيعي من الزراعة الهندية، مثل الموز في أمريكا الوسطى، لأنها تظهر في شبكة من البضائع القديمة المختلفة، الناتجة من كيان زراعي ومدني له تاريخ هام، إلا أن بضاعة البترول مختلفة فهي تظهر فجأة من باطن الأرض المجدبة وحولها قفار وصحارى واسعة، ومن هنا كان ظهورها وتفجرها يُربط بشكل سحري وأنه جزء من نشاط الجن.
لقد ظهرت عبر استكشاف غربي، علمي، فهي بضاعةٌ لها علاقة بتطور المحركات والطاقة، وبالبحث الغربي عن مصادرٍ لطاقةِ المصانع والآلات الضامئة أبداً للنار، وجاء هذا النشاط الاستكشافي ككل حركة علمية مرتبطاً بالحاجة الضرورية لقوى الإنتاج، وفي هذا الوقت كان التفسخ يتوالى على الأمبراطورية العثمانية آخر أمبراطورية جمعت المسلمين، فكان تفكيك هذه الأمبراطورية يتناغم مع انفتاح شهية الدول الغربية للاستعمار، ومع ظمأ المصانع لطاقة رخيصة كبيرة، فاشتغلت اليدان السياسية والعلمية على تقديم البلدان شبه الصحراوية و الصحراوية كبضاعة سياسية كبيرة على مائدة جوع العواصم الغربية وآلاتها.
وهكذا أختلفت بضاعة البترول عن بضاعة الشاي الهندي، فهي بضاعة مرمية في الصحراء البعيدة، لا تربطها وشائج بالمدن، وهناك شيوخ القبائل يمرون ويتغوطون دون أن يعبأوا بهذه الرمال الخالية.
فليس ثمة شبكة تربطها بمدن أو بزراعة، وليس ثمة أحد يملكها، فهي (معجزة).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبدالله خليفة: رأس المال الحكومي الشرقي ، منشورات ضفاف , بيروت 2016 .
عبــدالله خلـــــيفة: إبراهيم العُريّض ــ الشعر وقضيته
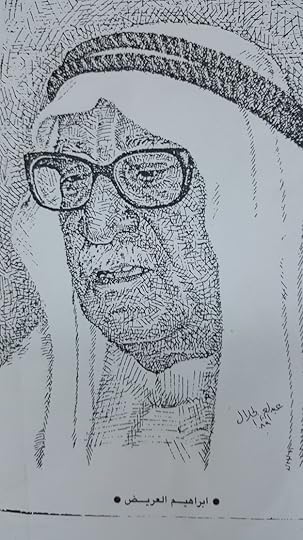
إبراهيم العُريّض
 الشعر وقضيته
الشعر وقضيته○ بيان العريض الشعري ودلالاته المضيئة الباقية
الشاعر والباحث الكبير إبراهيم العريض من الشخصيات القليلة في الجزيرة العربية والخليج الذي استطاع ان يبلور نظرة عميقة في رؤية الشعر وتطوره، حتى ان كتاباته النقدية والشعرية القصصية والملحمية لا تزال تخصب الواقع الثقافي وتحرض العقول على الكشف الادبي والبحث النقدي، خاصة كتابه (الشعر وقضيته في الأدب العربي الحديث). الطبعة الثانية سنة 1974، مطبعة حكومة الكويت.
الرؤية العربية الرصينة والكلاسيكية عند إبراهيم العريض كانت ضرورية للأجيال الشعرية الشابة في الجزيرة العربية والوطن العربي، لكنها ابتعدت عنها، ولم تتلاقح معها، وتستفيد من اعماقها وخبراتها.
الشعر لدى إبراهيم العريض كائن ذاتي وموضوعي معا، فهو وليد الذات الشخصية وتجاربها وعطائها، وهو ايضا نتاج الاحوال الاجتماعية والظروف الموضوعية. فالعريض يقوم بخلق جدلية عميقة بين ما هو شخصي وخاص وذاتي، وبين ما هو موضوعي وعام.
فما يصر عليه البعض من ان الانتاج الشعري وليد النبع الداخلي الخاص المحض، وشكل من تجلياته الغامضة غير المحددة في سياق، هو أمر مرفوض من الاستاذ الناقد، كذلك فان تصور البعض الآخر بأن الشعر والادب عامة، هو انعكاس للظروف الخارجية والعامة، هو أيضا امر غير صحيح.
والعريض يتغلغل أولا في الاسباب الموضوعية لتكون الشعر، معددا تجلياتها المتعددة، ابتداء من الظواهر الطبيعية المختلفة، التي تترك تأثيراتها المتباينة على نفوس ولغات الشعراء، مرورا بظروف الحياة، حتى الجذر العميق للحياة البشرية المتمثل في (العلاقات الاجتماعية التي عادة تنشأ جيلا بعد جيل بين أفرادهم، ذكورا واناثا وشيوخا وشبابا، وفئات واحزابا، ثم ظلت تتجدد وتتكاثر في المجتمع الواحد، وفي اكثر من مجتمع بين الرؤوس والاتباع، أو الملوك والسوقة، أو السادة والعبيد) ص 452.
هذه الاسباب الموضوعية هي التي يحددها العريض كأساس مادي لتشكيل الظاهرة الابداعية، الشعرية خاصة، فالانقسامات الجنسية والجيلية والطبقية، هي التي تلعب دورا حاسما في صنع الاساس الموضوعي العام للابداع.
والعريض في بحثه عن الجذور الخلفية للظاهرة الذاتية، يعتبر كافة العوامل السابقة ذات أدوار متساوية في صنع الظاهرة، فالاجيال والانقسام الاجتماعي تظل مؤثرات متكافئة ومتداخلة في تشكيل الأدب، ولا يلعب مؤثر منها دورا حاسما ومطلقا، مقتربا بهذا من نظرية العوامل المتعددة في صنع التاريخ والثقافة.
ومن خلال هذا الاساس الموضوعي لتشكل الشعر ينطلق العريض الى تاريخية الشعر وتوزعه على الزمن الاجتماعي، محافظا على هذا الهيكل المادي لتكون العملية الابداعية.
فهو يتبع الانواع الشعرية الثلاثة وهي الملاحم والمسرحيات والأغاني، أي الشعر الملحمي والدرامي والغنائي، في تجليها الاغريقي وخطها العلمي المستمر حتى الآن، معتبرا هذه الانواع أو الاصناف الادبية الرئيسية اساس تكون الظاهرة الشعرية العامة. وهو يرتبها حسب أهميتها ونموها التاريخي كذلك.
فالملاحم والمسرحيات الشعرية هي التي انبعثت أولا، في ظل الاحتفالات الباخوسية واحتفالات الشعوب القديمة بآلهاتها وأعيادها الربيعية والموسمية، ثم انبثق الشعر الغنائي بعدئذ، بعد انفصام المجموعات العشائرية وظهور الملكية الخاصة والشعور بالذات الفردية.
والعريض لا يقوم بتحليل أسباب تشكل هذه الانواع الشعرية تاريخيا، معيدا اياها الى جذورها الاجتماعية والروحية، لكنه يبحث عن أسباب تشكلها بشكل عام عند الاغريق، ثم تعثر تشكيلها عند الشعوب الاخرى، وخاصة لدى الهنود والفرس.
وهنا يقف العريض عند الأسباب الروحية في تشكل الشعر، حيث يرجع تطور اليونانيين الابداعي الى «نظرتهم» المؤنسنة للآلهة، وكيف انزلوها الى مصاف البشر، في حين كان عجز الهنود المسرحي يرجع لنظرتهم الصوفية، «وسموهم» بالإنسان الى مصاف الآلهة و«الزفانا»، أي الفناء في الوجود الأكبر.
وهذه الخلاصة هي نظرة مهمة للجانب الروحي وتأثيره الحاسم على الابداع، وان كانت المسألة تعود ايضا الى ظواهر متشابكة وأهمها المستوى الاقتصادي الاجتماعي للشعب الاغريقي، حيث المدن التجارية الحرة الديمقراطية، التي لعبت دورا حاسما في توجيه الارث الثقافي اليوناني، والشرقي القديم، نحو تعددية الاصوات، وتعميق ثقافة الحوار ــ الديالوج، والانسنة وحب الحياة والطبيعة، مما ولد الابعاد الدرامية خاصة.
في حين كان الشعب الهندي يعيش نظام الاستبداد الآسيوي والمشاعة الحرفية المغلقة، فتكون لديه نظام الطبقات المغلق والصوفية، وهي الحرمان المصعد والمتظاهر بالسمو. وهذا جعل نتاجه الشعري دينيا.
ويصل العريض هنا الى خلاصة هامة لافكاره، فيقسم الشعر الى منحيين، هما اللذان يخترقان ويشكلان ظواهره كلها، وهما المنحى «الواقعي» الذي يكون ذات الشاعر وخصوصيته، وهو ما نسميه في الوقت الراهن «الخاص»، وهو الذي يؤسس الشعر الغنائي والذاتي، حين ينطلق الشاعر متغنيا بأفراحه وآلامه، مصورا هذه الذات في تقلباتها وهجائها للآخرين أو مدحها لهم، وهي كلها ظاهرات ذاتية داخلية، لأن الشاعر يصف عواطفه واعجابه بدون تجسيدات موضوعية كأن يمسرحها في نماذج.
وهناك المنحى «المثالي» حين يخرج الشاعر من ذاته فعلا، عبر تقميص وتجسيد ذوات اخرى وشخصيات وأفكار مغايرة. وهو ما نسميه البعد الدرامي والملحمي للشعر، وهو أكبر من صفة «العام» المقابل للخاص. وأقرب تعبير له هو المنحى الموضوعي في الشعر. لأن تعبيري «الواقعي» و«المثالي» أقرب للفلسفة منهما للنقد الأدبي.
وتطور الشعرية لدى الشاعر هو في سيره من الذاتي الى الموضوعي، في نموه من ذاته نحو ذوات أكبر وتجسيدات موضوعية أشمل، كما يرى العريض.
ان الانواع الملحمية والدرامية هي الانضج والأهم شعريا، كما يرى العريض، في حين يبقى النوع الغنائي هو الأقل تطورا، ومن هنا، كما يضيف، نجد عمالقة الشعر الانساني هم صناع الملاحم والمسرحيات كـ هوميروس واسخيلوس وشكسبير وغيرهم. وهذا ما يجعل الشعر العربي ذا مكانة متدنية في الادب العالمي نظرا لسيطرة الغنائية عليه.
ان هذه الرؤية انقلابية في النقد العربي الحديث، فبدلا من أن يغدو الشعر العربي قمة من القمم في العطاء الشعري العالمي، يغدو في مكانة محدودة، نظرا لضعف الألوان والأصوات المتعددة داخله، وصدوره عن عالم صحراوي قليل العمق، مكرور التجربة، يعيد انتاج نفسه عبر الحقب، فلا يصنع ملاحم ولا مسرحيات بل قصيدة تصف وتمدح وتهجو، واذا تطورت في العصر العباسي فذلك عبر ادخال الفلسفة والحكمة داخل هذا الصوت الذاتي المسيطرة.
ويقول العريض هذا المعنى لكي يجنب عمالقة الشعر العربي كالمتنبي وأبي العلاء المعري ذلك الحيز الذي وضعهم فيه التصنيف النقدي الذي شكله.
والعريض مصيب في نظرته العمومية المجردة، فالشعر الغنائي ظل أقل مستوى من الشعر الملحمي والدرامي، نظرا لتأسيس هذين النوعين على بنى واسعة متكاملة تعتمد بنائية الصورة وتشكل النماذج والحبكات القصصية العميقة، التي ظلت تحاور البشر عبر العصور، رغم انطلاقها من ظروف مختلفة.
وعدم قدرة العرب على صياغة النوعين من الادب تعود لطبيعة تطورهم ومرحلتهم التاريخية. فهذان النوعان ارتبطا بالمرحلة الوثنية الطقوسية واحتفالاتها ومدنها وزراعتها، ومن الغريب المستبعد ألا تكون الشعوب العربية قبل الاسلام قد عرفت هذين النوعين، خاصة إذا عرفنا ان الشعوب السامية، الشجرة التي ينتمي اليها العرب، قد عرفت الملاحم الشعرية كملحمة جلجامش وغيرها. ويجوز ان تكون المرحلة الدينية الجديدة قد طمست الآثار الشعرية القديمة المرتبطة بتعددية الآلهة.
وفي وقت كتابة بحث الاستاذ العريض سنة 1954، لم تكن الدراسات الخاصة بوعي الشعري واللغوي والاسطوري قد وصلت الى ما هي علية الآن.
وكما شهد الشعر العربي تطورات جمة في النهضة العباسية، عبر نمو المدن والاحتكاك بالشعوب الاخرى. فانه شهد تطورات أخرى باحتكاكه بالحضارة الغربية ويعتبر العريض، مستشهدا بنازك الملائكة، أن أسباب التطور الشعري تعود إلى التأثر بالحضارات الأكثر تقدما وهذا أمر فيه بعض الصواب ولكن أمر التطور العميق يعود لتغيرات اجتماعية وروحية تجري في الأمة ذاتها يسرعها الاحتكاك الخارجي وينميها.
وهكذا فان الغرب ساهم في خلخلة العمود الشعري العربي. وخلق الأشكال الشعرية الجديدة، غير ان الدلالات والمناخ الفكري يعود للتربية العربية فالتطورات الفكرية المتصاعدة هي التي كسرت شكل القصيدة الكلاسيكية، وأفضت الى الاشكال الجديدة.
ومنذ وقت مبكر حذر العريض من الانطلاقات الفوضوية في شكل القصيدة، مطالبا بالحفاظ على بنية مرنة وكلاسكية، بل ومقدرا حتى قصيدة التفعيلة كما يكتبها نزار قباني، وكان هذا وعيا ناضجا لم تستفد منه الحركة الشعرية في البحرين كثيرا فيما بعد، نتيجة القطيعة بين الاجيال، وعدم أخذ تجربة العريض الغنية بعين الاعتبار.
في مختارات العريض للشعر المرافقة لهذا البحث، يقدم مختلف أنواع القصيدة الحديثة، والعديد من الاصوات الرومانسية والثورية والذاتية، معبرا عن تعددية جميلة ورصينة.
وكل الاصوات المتعددة التي يقدمها العريض كعبدالوهاب البياتي وفدوى طوقان وعلى محمود وايليا أبوماضي وأحمد الصافي والجواهري وعمر أبوريشة ونزار قباني، تؤكد الابعاد المتعددة التي يريدها العريض للصوت الشعري، وهي جزء من نظرته الى الذات الشعرية، حيث يعتبرها متعددة الموجات والمراحل، ولا يمكن سبر أغوارها، فهي لا نهائية التطور.
فالشاعر من الممكن أن يعبر عن اصوات متعددة، ومواقف مختلفة، ويلبس أقنعة كثيرة، وتبقى ذاته مستمرة التشكل، ولهذا فان الصنف الشعري الغنائي، المعبر بجلاء عن الذات، هو النوع المبسط، قليل العمق ومعدوم الاقنعة، في حين ان الصنفين الدرامي والملحمي هما الاقدر على اخفاء ذات الشاعر، واعطاء صوره بقاء وتنوعا، كما يتيحان له البقاء وسط التحولات والتقلبات.
نظرة الاستاذ العريض هنا لم تتوجه الى مسألة تشابك الاصناف الشعرية، حيث انه من الممكن ان تحوي أبعادا درامية وملحمية، والعكس صحيح كذلك.
ومن هذه الزاوية، يمكن رؤية جدلية الاصناف الشعرية، تعبيرا عن جدلية الانواع الادبية كذلك، فالشعر والقصة والمسرحية، يمكنها ان تتصل، محافظة على انواعها المستقلة. وفي النوع الواحد كالشعر، لا توجد حدود كبيرة، رغم أهمية الحفاظ على قانونية الصنف أيضا. فقد خلق احمد شوقي قصائد غنائية شعرية لا دراما شعرية.
وفي تجربة العريض المهتمة بالتشكيل الموضوعي للشعر، أي بتجسيده قصصيا وملحميا، كذلك، الغنائية المتفجرة، المتقطعة، الملتحمة. ومن هنا كان اعتماد العريض على التسلسل المنطقي والزمني والبنائية الصارمة، اقترابا منه لمعمار القصة المتعدد الاقنعة.
هل نقول ان كل ما طرحه العريض عن الشعر وأصنافه وذات الشاعر وأقنعته المختلفة، ليس سوى بيان العريض عن شعره وعالمه الابداعي الواسع؟
أليس كل هذا الوعي عن الآخرين وأفكارهم، سوى تجسيد لصوت العريض ونظراته؟
 القصة الشعرية عند إبراهيم العريض
القصة الشعرية عند إبراهيم العريض اشتهر الشاعر إبراهيم العريض كشاعر قصصي كبير، استطاع ان يخلق القصيدة القصصية الرومانسية الطويلة، بعد عمليات خلق شعرية دؤوبة، ان هذا الروح القصصي العالي كان مثار ملاحظة واسعة من قبل العديد من الدارسين والشعراء.
يقول عنها الاستاذ حسن الجشي في مقدمة ديوان العريض:
[ويبدو ان العريض اكتشف نزعة القص عنده من خلال قصيدة «مي» التي كانت تحتل مكانة بارزة في نفسه، ولعل فرحة الاكتشاف هذه هي لتي جعلت هذه القصيدة اثيرة على قلبه، بيد ان الاهم من ذلك انها كما قلنا بداية نقلة جديدة تحول بعدها العريض من القصيدة الغنائية البحتة التي ضاقت بأحاسيسه ورؤاه وخبراته الانسانية الى القصيدة الموضوعية ذات الطول المديد في حركة متطورة . .] ديوان ابراهيم العريض، طبعة دولة الكويت سنة 1979.
ويضيف الاستاذ الجشي داخلا الى نسيج تجربة العريض الشعرية القصصية:
[ان اكثر قصصه . . ذو بنية مركبة ولهذا نجد منه التعميم والبناء العضوي، والتخلص من الخطابة ومن الاسلوب الوعظي الذي يشيع في قصص مطران الشعرية . . وهو في هذا البناء يستخدم الحوار والمناجاة واحياناً المونولوج الداخلي . . ويتميز الرد القصصي عنده بطابع فني غالباً . .].
ويقول عن شعر العريض القصصي الاستاذ غازي القصيبي ما يلي:
[لقد ارادت طبيعة العريض له ان يكون روائيا وأراد هو ان يكون شاعراً فكان لكل منهما ما أراد، واصبح شاعراً روائياً، أو روائيا شاعراً، ان العريض لا يستطيع ان يكتب قصيدة دون ان يحولها الى رواية أو على الاقل اقصوصة] غازي القصيبي، قصائد أعجبتني، دار ثقيف للنشر والتوزيع، 1982، ص 69.
سنأخذ قصيدة «بين عشية وضحاها»، ص 145، من الاعمال الشعرية الكاملة، كمثال تطبيقي لهذا النفس القصصي، الذي لفت الأنظار وسنحاول فض بعض اسرار هذا النص الأدبي، في عملية نموه القصصي، بالدرجة الاولى.
القصيدة تتكون من فقرتين رئيسيتين، حددهما الشاعر برقم (1) و(2)، وبدا ان العنوان ينطبق على تقسيم الفقرتين، فالرقم الأول يقابله «عشية»، والثاني يقابله «ضحاها»، فهاتان الفقرتان الكبيرتان، تقسمان الزمن الى ماض، وحاضر، أو هما تجسدان حكاية، لها أولها، ولها خاتمتها، والفقرة الكبيرة الأولى هي عن الحاضر، الذي ينقلب الى ماض، والحاضر يبقى كنهاية للحكاية، وبين الماضي والحاضر هناك خط الحكاية المضفور من علاقة حب سريعة خاطفة بين فتى صياد وفتاة غنية، في ليلة عاصفة، في بنية اجتماعية متناقضة، لا تسعف الحب ان ينمو ويتشكل، وتؤدي بالحبيب الى الافتراق التام القاطع، ثم التلاقي بعد عشرين سنة، في موقع آخر، لم تتغير فيه البنية الاجتماعية المتناقضة، بل تغيرت احوال الحبيبين، فصار الفتى الصياد الفقير فناناً شهيراً، وصارت الحبيبة زوجة وأماً، وبقى شيء واحد لم يتغير هو ذاتا الحبيبين المفعمتان بحب فاشل.
هذه الحكاية لا يلقيها علينا الشاعر دفعة واحدة، بل هو يرسمها لحظة بلحظة، وينميها عبر الوسطين «الطبيعي» و«الاجتماعي» أي مظاهر الطبيعة وأحوال المجتمع، لكن سرعان ما ينزاح «الاجتماعي»، ليبقى «الطبيعي» مسيطراً على اللوحة، ولهذا فان التنمية الشعرية القصصية، عبر تشكيلها للمناخ المحيط بالشخصيتين، تعطي فرشة موضوعية، الى حد ما. وارضية لتنقل «البطلين»، تفسر بها افعالهما وحياتهما، ولكن نظرا لانزياح «الاجتماعي»، وسيطرة «الطبيعي» فان تلك الارضية تختفي.
في الفقرات الشعرية الصغيرة داخل الفقرة الشعرية الكبيرة، هناك محافظة كمية على عدد الابيات، حيث تبقى بشكل ثابت تسعة ابيات، ما عدا نهاية الفقرة الكبيرة الأولى، حيث يزيد بيتان، وما عدا نهاية الفقرة الكبيرة الثانية حيث ينقص بيتان.
الهندسة البنائية الدقيقة تتشكل منذ ضربات الفرشاة الأولى حيث التصوير للقرية بمناخاتها الطبيعية والاجتماعية، واللقطة الأولى هي لقطة عامة للقرية في شكلها الواسع، الرابض عند البحر، ويبدو واضحا طابع القص الذي يسيطر على العملية الشعرية، يقطعها ويوزعها، لكي ترسم ملامح الاشياء والظاهرات.
على شاطئ البحر في قرية تلـوح بعـزلتهـا الـدائمـة
كأن الدجى لفها بالسكون فما برحت دهرها نائمة
فتصوير المكان المحدود للقرية، سرعان ما يندفع الى رسم زمانها، ليندغم هذا الوقت الليلي، الغروبي، بحياة القرية العميقة، الغائرة وراء الظاهرات المباشرة، فكأن لحظة العزلة المكانية، والانحباس عند البحر، هو اللحظات الدائمة المستمرة لتخلفها، لنومها في الظلام، ومفارقتها «للحضارة» والمدنية.
فيغدو الانحصار المكاني، والظلمة، بوابة سريعة لدخول عالمها الداخلي الحبيس في العصور القديمة.
وليس الانحصار المكاني، إلا تتمة للانحصار الزماني، فالزمن رغم مروره الدائم فوق هذه القرية، إلا انها تبقى خارجة، فهذه الشمس «عروس النهار» تطل عليها، لكنها لا تلبث في جوها إلا «حالمة»، لا مغيرة، وهذا البدر يطبع قبلة طويلة، لكنها لا تؤدي الى خصب وتبديل، فيبقى كل شيء كما كان.
والوصف هنا متسلسل، متتابع، منطقي، تتداخل فيه بكثرة حروف العطف تربط بين الصور المنسابة بتلقائية، وتجمعها في لوحة مكثفة، تصف عالم القرية، حتى تصل في خاتمة الفقرة الصغيرة، الى كشف القوة المضادة لعالم القرية، انه البناء الشامخ المطل عليها.
وفوراً يكشف الشاعر، هذا التناقض الكبير في البنية الاجتماعية، التي يرصد بطله فيها. فهذا البناء:
يقيم به نائب . . أمـره مطاع . . وسطوته غاشمة
فلو ايقظ البحر امواجه لمــرت بــأعتــابــه لاثمــه
ان التداخل بين الاجتماعي والطبيعي يبرز هنا كذلك. فالقرية ليست محصورة في شق مكاني فحسب، بل في زاوية اجتماعية كذلك، فهي تنحشر اسفل هذا البناء الشامخ، وتركع تحت سياط هذا النائب ذي السطوة.
ويواصل الشاعر رصد هذا التناقض، عبر وصف شعور اهل القرية تجاه هذا «النائب»، وحياتهم الصعبة داخل تلك الأكواخ.
المقطع الصغير التالي يتجه لرسم صورة «البطلة»، الشخصية الأنثوية الرئيسية في الحكاية. وهذا الاتجاه الأول والاساسي للتركيز على الشخصية الانثوية ، ليس عفوياً، فهذا جزء من الوعي الرومانسي، النهضوي، تكون المرأة غالباً لدى العريض ينبوع الحب وبؤرة الصدام الدرامي ــ القصصي، وغالباً ما تكون هذه المرأة تعيش في عالم مبهر، غني، مرفه، وأيضاً: شاعري، وطاهر، فهي ليست سوى الجمال والنقاء اجتمعا في الانسان.
إن البطل ذا المنبت الارستقراطي، غالباً ما يكون محور الحكاية، أما البطل الفقير، فهو يخرج عادة من دائرة الوصف القصصي، وهذا يعبر عن حدود النزعة الرومانسية لدى الشاعر في تحليلها للحياة والنموذج الانساني، هذه الصورة الرومانسية لا ينثرها الشاعر في قصيدته، بل هو يخلقها عبر الفعل القصصي، الذي سيبدأ بعد، يتوقف تدفقه، مقطع مقتضب حول الطبيعة، وقد طالعتها هذه المرأة الشابة «الخود». حيث ترى الشمس في حالة عشق للإله، والبحر يصير انثى تلملم اردانها امام النسيم الذكوري، تغدو العلاقة بين النسيم والبحر علاقة حب مطردة وكأنها اشارة لما سوف يجري لاحقاً.
ومرة اخرى يظهر التضفير بين الطبيعي والاجتماعي، ولكن الاجتماعي الآن، هو النفسي المحض، المشاعر والعواطف، وقد انفصلت عن تربتها. يتم التركيز منذ الآن على عواطف المرأة والرجل.
فها هي المرأة ترى قارباً نشطاً يحمل فتية متجهين للصيد، فتعلن التمرد على القصر وتنطلق الى البحر.
مثل هذه الحركة القصصية تبدو غريبة، إبان الثلاثينات من هذا القرن، ولكن الشاعر لا يصف واقعة فعلية جرت في الخليج. أو في الهند، بل هو يشكل علاقة غرامية «خيالية»، استقت من بعض جوانب الواقع، لكن تم تغييرها واطلاقها، عبر هذا الوعي الرومانتيكي.
وتركيز الشاعر القاص على الفتاة، هو لكون المنبت الارستقراطي غير معبأ بمشكلات وتضاريس القرية، كما هو حال الفتى، وسوف يتيح نموذجها السياحة خارج التفاصيل الملموسة للواقع، فالمرأة سرعان ما تحررت من سجن القصر والقرية معاً، وطارت كالحمامة، أو النجمة، وبدا أن كل شيء في الطبيعة يمارس الحب معها، وخاصة هذا النسيم الذكوري الذي يقبلها فيصير ندى.
ولكن هذه اللقطات الجزلة، سرعان ما تتحول الى لقطات عاصفة، فيثور الموج. وينكسر زورقها، فتغدو الطبيعة عاملا داخلاً في الحدث كذلك، ومؤثراً ملموسا في تشكيل العلاقة بين الحبيبين المنتظرين، فتلك الكف التي سارعت لانقاذها من «الغيب» هي لذات الفتى الذي سيكون الحبيب، والتي تتعهدها بالعلاج وتسمعها الانغام الجميلة من عودها.
[ونعجب هنا كيف لم يقم القصر بحملة بحث عن الفتاة الضائعة، وكيف سمحت الظروف المتخلفة القروية لتلك العلاقة بين فتى وفتاة ان تنمو؟ انه الوعي الرومانسي في قطعه للمشاعر من سياقها البيئي، وامتلاك هذه المشاعر لطبيعة القص].
ان العواطف الطاهرة والموسيقى النورانية القادمة من وراء الغيب، كلها تجتمع لخلق العلاقة الغرامية بين البطلين، ويتشكل الحب تلقائيا عفوياً، وكأنه جاء من مصدر نوراني، وليس علاقة انسانية مباشرة.
ان هذه العلاقة الغرامية الرومانسية ــ الصوفية، هي فوق الوقائع المباشرة والملابسات اليومية، ولهذا فان كل التغيرات القادمة والسنين، لن تفعل شيئاً في تغيير «الداخل»، فما الخارج، بتكويناته الاجتماعية ومظاهره، سوى قشرة رقيقة «زائفة».
ولكن ثمة شيئاً ينفجر ويدمر هذه العلاقة، وهو مع ذلك جزء من هذا الخارج «العابر». انه انتماؤها للقصر، وعلية القوم، والاب النائب الشرس، ان التناقض في البنية الاجتماعية، بين القصر والقرية، يعود هنا، بصورة حديثة، مجسدة، عبر التناقض بين الفتى والفتاة.
لِمَ لَمْ يعتبر الفتى هذا التناقض جزءاً من هذه القشور الخارجية، ولم يكتف بالداخل النوراني العميق؟ لم حول هذا التناقض الخارجي الى بتر لهذه العلاقة «المقدسة»؟
ان الفتاة تقر بظلم أبيها، وهي تعود الى بيتها، في منولوج تعليقي على الحدث السابق، ولكنها تصل الى لحظة تنويرية خاصة، ان رد حبيبها على ظلم ابيها هو ظلم ايضاً، ولكن بحقها. إن الحبيب لم يتميز عن الأب، فلم ينسج من سيطرة الخارج، ليسمو فوق التضاريس الاجتماعية، بل انحشر فيها، ولم يرتفع كما ارتفعت هي، فأكتمل حبها وتطهرها.
وغــاظــك ان ابـي ظــالم ألست بظلمك لي صاحبه؟
وبهذه الفقرة انتهى الحاضر، وصار ماضياً، وانتقل الزمن عشرين سنة، تبدلت فيها الاشياء، وهي المظهر، ولم تتبدل القلوب، وهي الجوهر.
وهنا تبدو العلاقة منقطعة، معدومة، بين القرية والقصر، فلم يكن ثمة تفاعل، فالفتاة تنقطع كلية عن الفتى، وتتجه لخدمة زوجها واطفالها، وتنجب طفلة هي نسخة منها. وكأن دورة الحياة الرومانسية تعيد آليتها بشكل دائم عبر هذا التكرار. فأيضا الابنة هي قمة الفتنة والطهر والعذوبة، وهي ايضا ستتجه لرؤية البحار السابق، وقد تحول هنا، بعد دورة الزمن هذه، الى فنان موسيقي كبير.
والشاعر القاص لا يضيع نسجه القصصي هباء، فرغم استطالته في وصف الابنة، إلا انه يستخدمها كصورة من الأم فقط، وكوسيلة لتنمية الحدث القصصي، وبعث المشاعر الداخلية العميقة التي لم تمت، فلقد هصرت سنوات الزواج المرأة، واذبلت ابتساماتها، ولا تشتعل هذه الابتسامة إلا عندما تذكر حبها القديم، والبحار المنقذ، فكأن الزواج هو جزء من الظاهر، والحب هو وحده الفرح الحقيقي المفقود.
وتتجه الأم والابنة الى الحفلة الموسيقية، وتكون ثمة صدفة جديدة في سلسلة المصادفات، أو قمتها، وهي الالتقاء بالبحار السابق، الموسيقي حاليا، وهو يعزف العود ويحرك الجماد.
ان هذه اللقطة الأخيرة، هي قمة كل المشاعر والحدث، فالموسيقي يرى المرأة، ويعرفها بسرعة، فمظاهر العشرين سنة لا تستطيع ان تحجب الجوهر، ويعزف بوله لها، ويندم في غنائه على تضييعه للحب، وتسأل الفتاة امها، عن هذا المغني المعذب، فتخبرها الأم، ببساطة، انه أحبها يوما، وليست كلماته الغزلية، المشبوبة الاداء الآن، سوى كلمات طالعة من قلب اقفر ومات! وتنتهي الحكاية.
وهكذا عندما وصل الفتى البحار، الموسيقي الناضج حاليا، الى ذات الموقف الرومانسي المكتمل، تكون هي قد ابتعدت عنه، رغم ان ذاتها كانت مليئة بحبه.
هذه المفارقات العاطفية سببتها تلك البيئة الاجتماعية المتناقضة، والوعي المندس في شقوقها، لا الطائر المحلق بعيدا عنها، ان الموسيقي الآن قد حل اشكاله الخاص مع البيئة، وارتفع، ولم يعد بحاراً فقيراً، ووصل الى مرتبة الحبيبة الاجتماعية، والآن هو قادر فحسب، على ان يحبها حقا، وان تكون له، ولكنه لم تعد له.
ان التمسك بالبيئة الاجتماعية ومراتبها، هو قشور حسب وعي إبراهيم العريض ورؤيته الرومانسية، سواء كان هذا التمسك سلباً ام ايجاباً، ثورة أو قمعا، وهذا هو سر المأساة. فلو ارتقى البحار في تلك اللحظة القديمة، عن غضبه، وارتقى الى «الجوهر» الانساني، الى النقاء والطهر الروحي، بعيدا عن «مظاهر» الفقر أو الغنى، القرية أو القصر، كما فعلت الفتاة «النقية» لكان سعيدا الآن.
هنا نرى رؤية العريض، التي ترى الصراع الاجتماعي، ولكنها تعتبره من القشور، لأن الجوهر الانساني الخالد يسمو فوقه. ولا يمكن للفنان ان يبقى حبه إلا بالسمو فوق النزاع «العارض»، ولا يحدث الرقي والنور، إلا عبر هذا التجاوز للتضاريس الاجتماعية ولا يمكن للقرية، بالتالي، ان تصعد، للنور، للنهضة، إلا عبر هذا التسامي.
وإذا كانت القرية ككل لم تصعد، فان الفنان ابنها، ارتقى، عبر احدى أدوات النور، وهو الفن، وحين وصل، الى ذات المكانة الاجتماعية، اكتشف، ان كل تلك المستويات المتناقضة، هي مجرد مظاهر، ولكن في اثناء الرحلة، كان قد فقد حبيبته.
ان آلية الوعي الرومانسي تتحكم في البنية الفنية هنا، فالطبيعة قوة اساسية متداخلة ومؤثرة في الاحداث والمشاعر، وتمتلك كينونتها النقية، والمشاعر المرتفعة فوق الزمان والمكان هي القوة المهيمنة في نسيج الحياة، وهي كالمواهب والأفكار من مصدر علوي، والصدف هي التي تلعب الدور الحاسم في تنمية الاحداث، كوجه من اوجه تجلي القدر المهيمن على نسيج العالم.
والشاعر يعتمد في تجسيد هذا الوعي الرومانسي على قوانين نمو الحدث القصصي في جزء من الواقع. فيجسد الجو العام للحكاية، وينمي الحدث، ويرسم الشخصية المحورية، من خلال تصاعد الحدث، لكن هذا الحدث ينسحب تدريجيا من أفقه الاجتماعي، ليجنح في عالم المشاعر، وهي مشاعر شخصية واحدة، اثيرية، حالمة، وليس عبر تعدد المشاعر وتناقضها، وحتى حين يحدث التناقض النفسي يدور في سياق العاطفة الرومانسية وحدها.
 من المعارك الادبية في البحرين
من المعارك الادبية في البحرين ○ إبراهيم العريض في مواجهة كاتب مجهول
مقابلة صغيرة قامت بها مجلة «القافلة» في سنة 1954، بالبحرين مع الاستاذ إبراهيم العريض ادت الى حدوث مناقشة أدبية ساخنة لبعض قضايا الأدب، وطرحت أسئلة جوهرية حول ماهية الأدب وعلاقته بالمجتمع. سوف نقرأ جزءاً من هذه المقابلة، وبالأخص المقاطع التي استدعت الحوار بادئ ذي بدء:
القافلة . . تسأل والأستاذ إبراهيم العريض يجيب:
● أنت ــ وإن تواضعت ــ استاذ روحي لجيل من الشباب البحريني الحي وأديب عالمي . . فما هي النصيحة التي تقدمها للأدباء الناشئين من الجيل الجديد؟
○ نصيحتي للأدباء الناشئين من الجيل الجديد بألا يقطعوا صلتهم بمصادر الثقافة العربية القديمة. فبدونها لا يمكن أن يقوم للعرب كيان قومي. وهلكت أمة لا تاريخ لها. ولست أعني بهذا بأن يعيشوا عالة على عصرهم فان لكل عصر مشاكله الخاصة. والشعب الذي يتنكر لشئون عصره يصبح في حكم الأموات إذ تلفظه الحياة.
ولقد كانت مصيبة الأمة العربية طوال العصور هي في تصور أبنائها انهم يستطيعون ايقاف عجلة الزمن.
■ المثل الأعلى للجمال
● ما هو المثل الأعلى للجمال؟
○ الجمال نسبي. فلا يمكن أن يكون له مثل أعلى. فكل ما هذب ذوقك ووسع احساسك بالحياة وزادك بها على تطاول العمر متعة وسروراً وكان عاملاً على رفع هذه الغشاوة عن عينيك بحيث ترى الدنيا زاهية الالوان لا مجرد سواد أو بياض. كل ذلك بالنسبة اليك والى من لهم علاقة بك هو الجميل.
● يتهمك كثير من المعجبين بك بأنك انطوائي تضن على أبناء مجتمعك بما من الله عليك من شاعرية فذة وتفكر سليم . . لماذا لا تحاضر في الأندية الادبية فترضي المتعطشين الى ادبك؟
○ لا أدري كيف يجتمع الاعجاب والتهمة في آن؟! على ان كلمة «انطوائي» مطاطية تستطيع أن تحملها ما شئت من معنى . . ولن تصل بها الى نتيجة. ولو أردنا التحديد لقلنا ان من الادب ما يعالج مشكلة الفرد في ظروفه الغابرة وهي لا تتجاوز زماناً بعينه في هذا المكان أو ذاك، كالقضايا التي تعرض على المحاكم أو كالوصفة الخاصة التي يصفها الطبيب الى مريض مثلاً تحت العلاج، فهذه لا بد من تغيرها من يوم الى يوم. وكذا أدب الصحافة. ومن الادب ما يتجاوز هذه النظرة الضيقة الى أفق الحياة الأوسع حيث تلبس المشكلة رداءها الانساني وتخرج من نطاق الفردي بحيث يسري حكمها على «الإنسان» في كل زمان ومكان فلا تعود قضية خاصة.
ويضيف الاستاذ العريض:
ولقد كنت دائماً أهتم من الادب بهذا الجانب الذي يرى المشكلة انسانية قبل كل شيء، أي لا تخص زيداً أو عمرواً من الناس فحسب بل تتعداهم الى «الإنسان» الجانب الذي لا يتقيد لذلك في الحكم لها أو عليها بظروفها العابرة التي قد تختلف باختلاف الأحوال. ولعل من هنا فضل القصة ــ عند بعضهم ــ حتى على وقائع الحياة. وصح اعتبارها باباً من أبواب الادب الرفيع اليوم وان كانت محض خيال، وترى لذلك شعري كله قصصاً . . حتى ما دار منه حول مأساة فلسطين.
■ أين الحقيقة؟
ويثير هذا الرأي حفيظة أحد القراء ــ ولا أظنه إلا أحد الكتاب ــ فيكتب في زاوية «آراء حرة» مقالة بعنوان «أين الحقيقة!»:
اريد أن أقول للأستاذ العريض ان هذا الادب الصحافي الذي يعالج هذا المجتمع الصغير. الذي هو جزء من المجتمع الانساني الكبير هو أدب انساني ايضاً، وكذلك أرض الشهداء. أما اخت شيرين وورقة التين وبيني وبينها وزهرات من خميلة الخيام وغيرها فليست أدباً انسانياً وليس الاستاذ العريض أديباً بالمعنى المفهوم، أديباً لا يجده زمان ومكان كطاغور مثلا الذي تغنى ببلاده وصور ريفها ومدنها وعاش وطنه بقراه وسهوله وبساطته وغموضه حياً خالداً في ادبه.
اما ما (يقوله) الاستاذ الفاضل على الادب اليوم من أن القصة تأخذ مجالاً بارزاً فيه ويفضلها بعضهم حتى على وقائع الحياة رغم انها خيال محض (فخطأ) الآن. الأدب اليوم لا يحتضن من القصة إلا ما يصور وقائع الحياة ويعالج المجتمعات الانسانية قبل كل شيء. فـ غوركي وهوارد فاست وتولستوي وغيرهم من أعلام القصة لم يكتبوا خرافات وأساطير خيالية، وإنما كتبوا قصصاً واقعية من صميم الحياة (….) فمن صميم الشعوب اغترف هؤلاء العمالقة أدبهم، من وقائع الحياة، لا الخيال المحض.
هناك تناقضات عديدة بين رأي الاستاذ العريض وذلك الكاتب المجهول. انهما يقفان على طرفي نقيض، ويتقبلان بشكل غير جدلي، الأمر الذي يشير الى وحدة الرؤية رغم الاختلاف.
محاولة للقراءة
سنحاول هنا أن نقرأ الحوار على ضوء وقته.
للعريض تصور خاص ذاتي للجمال وهو ان الجمال ما يجعل عينيك تريان كل شيء زاهياً. ان «الجميل» هنا هو أمر خاص بالفرد، بالذات الخاصة المنعزلة عن الآخر، فكل ما يجعلها تتمتع وتسر كان جميلاً.
لكن لدى الكاتب المجهول ان الجمال هو في رؤية الواقع على مرارته. ان تركيزه «الواقع» و«الحياة» و«الوطن» وان في اكتشافه رغم وجود السوء والقبح والتعاسة فيه، هو الأمر الباعث والخالق للجمال في الادب، هو أمر هام هنا جداً. فالكاتب يريد جر العريض الى مصدر الجمال ومقياسه الحقيقي والموضوعي، وليس الى الذات وأحاسيسها الفردية المنعزلة.
وتتضح شقة الخلاف بين المفهومين عندما يؤكد الاستاذ العريض ان الادب لا يعالج مشكلة الانسان في «ظروفه العابرة» بل يتجاوز المكان والزمان.
أما الكاتب فيرى على العكس ان في الغوص وراء هذه «الظروف العابرة» والاتجاه الى الواقع بكل مظاهره وبشره هو مهمة الادب.
وحقاً كيف يمكن الارتفاع عن «الظروف العابرة»؟ وهل يمكن للأدب أن يكون خارج الزمان والمكان؟
ولم يكن أدب العريض نفسه خارج الزمان والمكان، بل كان داخله، ولكن اتجه الى مناطق بعيدة وأزمان مختلفة، الى «فلسطين» والى «الاندلس» وغابت ملامح البلد، أي البحرين، في زمن العريض ذاته، عن أدبه بشكل واضح.
أي ان الخلاف ليس هو حول الخروج من الزمان والمكان بشكل مطلق، وذلك مستحيل، ولكن الخلاف يتركز على الخروج من زمان ومكان محددين والزمن هو النصف الثاني من القرن العشرين والمكان هو: البحرين.
ان الادب المتواضع المتواجد حينذاك حاول أن يتجه بقوة الى الحياة، وكان أدباً «صحفياً» كما وصفه العريض. لأنه اهتم بالكثير من القضايا «العابرة» فعلاً كتعدد الزوجات، ضرر الطلاق، الشعوذة . . الخ.
ان هذا حقاً لم يتوغل في الحياة، ولم يتجذر فيها بسبب ان الوعي الفني المتشكل حينذاك فحسب لم يكن بعيداً عن «الوعي الصحفي» كانت الرغبة في التأثير السريع، وكذلك عدم التمكن من فهم واستيعاب ادوات الادب والفن، ومناخ الخطابة السائد، من الأسباب التي أدت الى عدم تحول هذا الادب الصحفي الى أدب حقيقي.
ولكن على الرغم من ذلك فلو ان الادب الصحفي قدر له ان ينمو في بيئة صحفية مستمرة، ومناخ مزدهر، لأمكنه فعلاً أن يتجاوز صحفيته وسرعته الى الادب وهذا ما بدأ يتشكل بعد ذلك في مرحلة تالية من نمو الصحافة البحرينية، ولكن مع فارق جوهري هو نمو وعي اجتماعي مختلف.
■ تضــاد غير جـدلي
ويتضح التضاد غير الجدلي بين العريض والكاتب المجهول في الحديث عن «الخيال» فالأدب لدى العريض هو خيال محض، فهو يعتبر القصة من أبواب الادب الرفيع وان كانت «محض خيال». وهنا يبدو الخيال في تصوره متعارضاً بشكل مطلق مع الحقيقة والواقع.
أما الكاتب الآخر فيندفع الى الجهة المعاكسة تماماً فيرفض ذلك «لأن الأدب اليوم لا يحتضن من القصة إلا ما يصور وقائع الحياة . .» فيبدو الخيال هنا خارج الادب، فينتمي الكاتب بهذا الى «الوقائع» الى «صميم الحياة» بينما العريض يتوجه كلياً الى «الخيال».
هنا نجد مفهوماً غير حقيقي عن الادب، فالخيال ــ وهو ميزة جوهرية في الابداع ــ يقف على طرف نقيض من التصوير الادبي الذي يجب ان يكون «واقعياً» أي بمعنى أن يسجل ويعكس بشكل حرفي ما يدور في الحياة.
وهذا الرفض للخيال، رغم خطأه الطفولي، مبني على عداء واضح للأدب الذي لا يتجه لاكتشاف الواقع، للأدب المنتمي الى مدرسة «الفن للفن».
نجد أن ثمة نقيضين هنا لا يتآلفان جدلياً: الواقع المباشر والخيال، فالأدباء الحقيقيون في تصور الكاتب المجهول هم المتجهون الى هذا الواقع والمبتعدون عن الخيال، الذي ليس سوى هروب وكلام فارغ. أما في تصور العريض فالأدباء الحقيقيون هم المغمورون بهذا الخيال والمبتعدون عن هذا الواقع المباشر المتغير الزائل الصالح للصحافة.
ان ادب العريض كما لاحظ الكاتب فيه الكثير من تجاهل الواقع المحلي، تجاهل للفقر والعذاب والاضطهاد الاجنبي انطلاق الى قضايا وجدانية شخصية أو اتجاه لأدب يتحدث عن قضايا «قومية». انه أدب يفتقد التماس مع الواقع البحريني، فهو أدب بهذا المعنى، غارق في الخيال، ويسكن «البرج العاجي» ولا ينزل الى السوق والحارات.
في تلك الفترة، أي في سنة 54 وما تلاها، كان ثمة زخم وطني تحرري كبير في البحرين، فقد اندفعت الطبقة الوسطى للصراع المباشر مع الانجليز واستغلت الصحافة والأندية وكافة الاشكال المتوفرة لنشر الوعي واستقطاب الناس لآرائها.
وكان العريض بؤرة أدبية هامة، وشخصية لامعة على المستويين المحلى والعربي، فكان أمر جذبة لهذا الصراع الدائر، والاستفادة من كتاباته وآرائه، مطروحاً بقوة لدى المثقفين البارزين في الطبقة.
وكان هذا الحوار والتعليق ــ الذي يبدو انه من أحد كتاب المجلة نفسها ــ والمناقشات التي تلت هي جزء من عملية التأثير في هذه الشخصية الادبية البارزة.
لكن المسألة كانت أكبر من ذلك. فإبراهيم العريض قد كرس لنفسه منحى مختلفاً، فهو ذو علاقة وثيقة بالوضع السائد، وقد أبعد أدبه بشكل عام عن نقد هذا الوضع، واتجه الى موضوعات بعيدة محافظاً بهذا على استمراريته في الكتابة وعلاقاته معاً.
■ الموقــف والظــرف
ان «الظروف العابرة» وهو التعبير الذي ورد في الحوار معه يشير الى هذه الأحداث الصاخبة في الخمسينيات والمشكلات السياسية المتفجرة، وهي قضايا رئيسية وكبيرة ولكنه يعتبرها «عابرة» و«هامشية»، والمهم لديه هو الدخول الى القضايا التي تبقى وتستمر خارج هذه الظروف المتغيرة.
وهذا الرأي غير الجدلي، الذي لا يربط بين الآني والمستقبلي ولا يتصور العلاقة الوثيقة بين المشكلات الحالية ووضع الانسان العميق، يريد في الحقيقة أن يبتعد عن اتخاذ موقف تجاه الواقع.
ان ظروف الخمسينيات لم تكن ظروفاً عابرة، بل كانت صراعاً جوهرياً وأساسياً ليس في البحرين فحسب ولكن على مستوى العالم ان الصراع بين الشعوب والاستعمار هو صراع أساسي وملمح رئيسي من ملامح تاريخ الانسان المعاصر.
انه صراع ملحمي له ظلاله المختلفة، فهو صراع القديم والجديد، الشر والخير، السلبي والايجابي، اللااخلاقي والاخلاقي، السيطرة الاجنبية والتحرر، الاغنياء والفقراء الـخ . . وعلى ذلك فهو مادة هامة جداً للأدب.
ونفس هذا الصراع كتب عنه العريض، ولكن عندما تعلق بفلسطين، أي انه لم يكن ضد الكتابة عن هذا الصراع «العابر» بشكل مطلق!
ان الكاتب المجهول كان يعرف ذلك، وتفريقه بين كتابات العريض المختلفة دليل على ادراكه الصحيح لجوانب أدبه المتناقضة، ومحاولته لتوجيه هذا الادب نحو الواقع المحلي، أي لحل التناقض داخل ذلك الادب!
وهو في طرحه أسماء مثل «غوركي» و«هوارد فاست» و«تولستوي» قد استوعب بحسه ان الادب العميق يستطيع أن يضفر بين المشكلات الآنية وأوضاع الانسان الجوهرية، فليس ثمة تناقض بين تحليل الانسان في واقع محدد، وان يكون الادب باق وخالد. بل على العكس ان تأثير الادب في الاجيال القادمة نتاج ادراكه العميق لمشكلات وقته.
لكن الكاتب المجهول لم يستطيع ان يستوعب ذلك نظرياً، اضافة الى ان الفهم المنتشر للأدب وقتذاك بين طليعة المثقفين هو الادب المتجه لمعالجة قضايا مباشرة. وليس ذلك الادب الواقعي الرفيع كما وصل لدى تولستوي وغوركي.
ان وعي مثقفي الطبقة الوسطى تركز على شحن الناس ببعض القضايا والهموم الساخنة وبشكل قريب من الصحافة وليس الادب. كما لم يكن بإمكانهم التغلغل الى عمق مشكلات المجتمع ونماذجه.
وأسباب هذه الظاهرة ترجع لتاريخية هذا الوعي. فهو وعي لم يكن يقف فوق أرضية صلبة من النهضة التعليمية والثقافية، كما يرجع للطابع «المؤقت» لصراع الطبقة ضد الاستعمار، فهو صراع تريده سريعاً، خفيفاً، يتركز حول بعض المطالب الهامة وليس صراعاً يتجه لتغيير شامل وجذري.
هذا ما يتعلق بالطبقة «الوسطى» القائدة للزخم، أما الناس فكانوا في وضع ثقافي متخلف جداً، ولذا كانت مشاركة المعبرين عن طموحهم في الادب، تكاد أن تكون معدومة.
■ التحــديث والتغــريب
من هنا كان العريض غير ملتفت الى هذا النوع من «الشغب» الادبي، فقد عمل من بداية الثلاثينات في نشر وعي مؤمن بالحضارة الغربية وقيمها. وكان التحديث لديه لا يصطدم بذلك التملك الاجنبي، بل على العكس يفترض الصداقة والتعايش معه.
ونجد في المقابلة ايحاء بذلك، فهو بعد أن يوجه نصحه للأدباء الناشئين بعدم قطع صلتهم بمصادر الثقافة العربية القديمة يطالبهم بعدم الوقوف عند تلك المصادر والانقطاع اليها ثم يضيف «ولقد كانت مصيبة الامة العربية طوال العصور هي في تصور أبنائها انهم يستطيعون ايقاف عجلة الزمن».
لقد كان الصراع الفكري وقتذاك يدور بين تيارين فكريين هامين استحوذا على وعي مثقفي الطبقة الوسطى وهما التيار القومي بروافده وبين التيار «التحديثي» الغربي.
وإذا كان التيار الاول هو الذي قاد عملية الانطلاق الوطني وكرس الاهتمام بالتراث بدرجة اساسية فان التيار الآخر كان في موقع الرفض لتلك الانطلاقة والتأكيد على منحى آخر.
فاستعادة المواقع التراثية، أو العودة الى الماضي العربي الزاهر، أو توقف الزمن على حد تعبير العريض، لن يؤدي الى نتيجة حقيقية، فالزمن يندفع باتجاه الغرب، والتماثل معه والذوبان فيه. وهذا هو الحل!
من هنا تصور العريض ان ذلك «الشغب» سيكون «عابراً». وان الطبقة الميسورة «المأزومة قليلاً الآن» والمتمردة ستعود من جديد الى الحضن الدافئ. وهذا ما كان فعلاً فالأغلبية الساحقة من مثقفي البرجوازية البحرينية تركوا تلك القضايا العابرة الساخنة واندمجوا في المناخ العام الدائر حول المركز الغربي. وما عادوا يرددون أسماء تولستوي وغوركي، بل ان الحياة الادبية الجديدة في الستينيات عندما استعادت هذه الاسماء بشكل اكثر نضجاً اثيرت زوابع حولها!
■ ســــوء تفـاهـــم
ان اهتمام العريض لم يكن موجهاً لإلغاء «التغريب» بل على العكس كان يؤكده. ولهذا راح يؤكد من بداية الثلاثينيات على قيم «العلم» و«التعلم» و«الفن والأدب الانساني» و«حرية المرأة» و«الحب» و«العقل» و«النهضة» . . وكل هذه هي معايير للطبقة الوسطى «الخالدة» أي ان هذا هو برنامجها عبر كل المراحل والتطورات الآنية.
أما أن تتجه الى أبعد من ذلك فهو أمر «عابر»، نتاج أزمة طارئة، ولحظة صدام لا تلبث أن تزول، وسوء تفاهم «عائلي» ومن ثم تعود الامور الى مجراها الطبيعي.
ان العريض بحسه كان يفهم طبقته التجارية العقارية، التي تعيش بالتوكيلات الاجنبية، وغير الصناعية، وغير الواسعة والمحاطة بأناس أكثر حدة وجذرية منها، لهذا فهم الشاعر الافق البعيد لها.
لقد شارك في أوائل الخمسينيات في كل نهضتها الادبية، بل وكان من الممهدين لمثل هذه النهضة، ولكنه لم يؤيد فورتها الآنية. وبقى «منعزلاً» و«انطوائياً» عن ندواتها وأدبها الصحفي الصاخب السريع، منتظراً انتهاء عاصفتها.
وسرعان ما ارتدت الطبقة الى رؤية واندمجت في المناخ «التحديثي التابع» ولم تعد تطرح بعد ذلك الدرس القوي أي تغيير جذري وصمت كتابها وابتعدت عن الادب الساخن العابر، بل وعن الادب برمته!
 المثقفون البحرينيون وإبراهيم العُريّض
المثقفون البحرينيون وإبراهيم العُريّضلسنوات طويلة ظل الأستاذ إبراهيم العريض الشاعر والناقد الوحيد الهام المعروف من البحرين، ولربما من منطقة الخليج والجزيرة كلها، وظل اسمه يتردد في المحافل الادبية والمجلات الثقافية العربية المشهورة، منذ الثلاثينات وحتى الستينيات.
لقد قام العريض بإبداع جوانب جديدة في أدب المنطقة، وواكب نشوء القصيدة الرومانسية واسهم بنصيب وافر من انتاجها، واتجه الى خلق الملحمة الشعرية، ثم ركز، بعد وفرة الإنتاج الشعري والملحمي، على كتابة النقد وتحليل الشعر، بدءا من نظراته النقدية المتفردة إلى أدب المتنبي وانتهاء برؤيته للإنتاجات الشعرية العربية المعاصرة له حينذاك.
والملاحظ في هذا الإنتاج الشعري والنقدي الوفير، قلة الاهتمام برصد الثقافة في المنطقة، وعوالم الحياة فيها.
ان انتاجه الشعري يرتكز على موضوعات تراثية أو عربية بعيدة كقضية فلسطين، وهو نتاج يحوم بعيدا عن مشكلات وطنه وقضاياها، الأمر الذي جعل العريض ظاهرة ملفتة للنظر، ومحل تساؤل وخلاف، من قبل التيارات الادبية التي تشكلت وتغيرت طوال هذه الحقبة المديدة.
لقد كان العريض مثار اعجاب مثقفي الثلاثينات والأربعينات البحرينيين، الذين رأوا عربيا فتيا يقدم من الهند، وهو لا يكاد يفقه من اللغة العربية شيئا، ويقوم بتعلمها واستيعابها والتفوق فيها الى درجة ان يصبح فقيها فيها ومرجعا لشواردها وعوالمها القصية.
ثم لا يكتفي بذلك بل يصبح ضليعا في لغة ثالثة هي الفارسية، اضافة الى عبقريته في اللغة الانجليزية التي ينتج بها شعرا!
ثم يقوم بالتجديد في أنواع الأدب. يؤسس المسرح التاريخي ويشكل القصيدة العاطفية النابعة من الأنا، غير المادحة والمتسولة، التي تعج بظاهرات الطبيعة الحية. ويطور هذه القصيدة الى ان تكون قصة، لها كل خصائص القصة، من شخصيات وأحداث وعقدة ونمو، وتتحول هذه القصة ايضا الى ملحمة، تتطور كثيرا عن أن تكون قصة محدودة لشخصيات مغمورة، بل تكون قصة لقضية كبيرة.
هذا كله جعل المثقفين «البسطاء» حينذاك يرونه كبيرا، ورمزا لما يريدون أن يقوموا به من انهاض للثقافة والمجتمع.
وقد قام المثقفون المتنورون حينذاك بتأسيس مجلات نهضوية هامة في المنطقة كـ«صوت البحرين» و«القافلة»، واتجهت الثقافة العربية في منطقة الخليج إلى التطور، والتغلغل في ظاهرات الحياة وأزمات المجتمع ووجود المستعمر، مما أدى إلى بروز انواع ادبية جديدة، كالقصة الواقعية والمسرحية «الاجتماعية» الارتجالية وغيرهما.
ومن هنا وجه هؤلاء المثقفون الجدد نقدا الى ا
December 29, 2020
عبـــــــدالله خلــــــــيفة : المفكر اللبناني كريم مروة
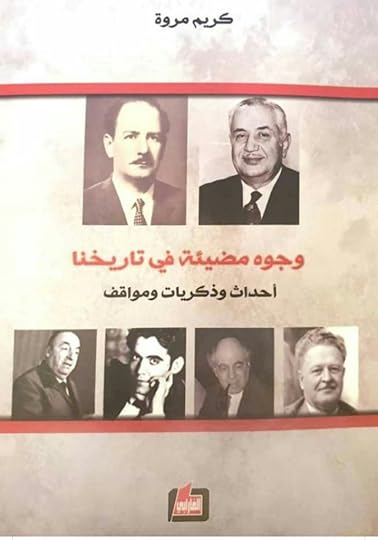
القائد والمناضل عبـــــــدالله خلــــــــيفة
مفكراً وأديباً وروائياً بحرانياً
تميّز عبـــــــدالله خلــــــــيفة بالجمع في شخصيته بين المفكر اليساري والأديب والروائي والمناضل الذي لم يتراجع في كل الظروف عن أفكاره وعن مواقفه. وقاده إلتزامه بأفكاره التي دافع عنها بشجاعة الى السجن اكثر من مرة. لكن من اهم ما عرف عنه وهو في السجن، الذي أدخل إليه في عام 1975 من موقعه في قيادة جبهة تحرير البحرين، أنه لم يترك القلم لحظة واحدة. وصار معروفاً أنه ألّف عدداً من كتبه ومن رواياته على وجه الخصوص داخل السجن على ورق السيجارة. وكانت تهرّب إليه الأقلام و أوراق السجائر ليمارس عمله الأدبي و الفكري. وكانت تهرّب أعماله الأدبية من السجن و يعاد طبعها بانتظار خروجه من السجن لكي يتم نشرها. وهو بتلك الصفة التي ندر شركاؤه فيها تحوّل الى أيقونة بالمعنى الحقيقي المناضل اليساري الحقيقي و لصاحب الفكر النيّر.
تعرّفت الى عبـــــــدالله خلــــــــيفة عندما زرت البحرين في عام 2000، العام الذي كانت قد تحولّت البحرين من إمارة الى مملكة ذات دستور شبيه بمعنى ما بدساتير الممالك الدستورية. لبّيت يومذاك دعوة المنبر الديمقراطي الذي صار الناطق باسم جبهة تحرير البحرين والبديل منها في الشروط الجديدة. وأشهد أن تلك الزيارة قد عرّفتني الى تاريخ البحرين القديم والحديث. كما تعرفت في الآن ذاته الى العديد من قادة جبهة تحرير البحرين القدامى وقادة المنبر الديمقراطي الجدد. وكانت لي صداقات أعتز بها مع عدد من قادة جبهة التحرير، لا سيما في الزمن الذي كانت الإمارة قد انفتحت على القوى الداخلية والخارجية في عام 1973، وأجرت انتخابات نيابية نجح فيها ثمانية من أهل اليسار.
وكنت قد زرت البحرين قبل ذلك غير مرة في طريقي الى الهند واليابان و الفيتنام. ولا أنسى فرحي في احدى تلك الزيارات في عام 1980 عندما وجدت في المكتبات كتباً لمهدي عامل و كتباً لماركس.
في تلك الزيارة الأخيرة المشار إليها تعرّفت الى طبيعة التحول الذي كان يحصل في ذلك التاريخ في البحرين. وقد دعيت الى عدد كبير من الندوات التي تحدثت فيها عن قراءتي لذلك الحدث، الذي كان من أبرز عناصره الى جانب تحول البلاد من امارة الى مملكة دستورية، القرار الذي كانت قد اتخذته السلطات بالافراج عن جميع المعتقلين واستدعاء الذين عاشوا في المنفى لممارسة حريتهم في البلاد والسماح في تشكيل جمعيات واحزاب و نقابات ومنابر. وكان ذلك حدثاً مثيراً للدهشة في ذلك التاريخ وفي ذلك الموقع الجغرافي بالتحديد. وكان من بين الذين إلتقيتهم وزراء في السلطة الذين تحدثت إليهم عن معنى ذلك الحدث.
إلا أنني و أنا أستحضر اسم عبـــــــدالله خلــــــــيفة كمفكر وأديب وروائي مناضل لا استطيع الا ان اعلن لنفسي وللقارئ كم كنت معجباً بهذا الانسان. فهو الى جانب ما أشرت إليه من صفات فكرية وأدبية وسياسية كان إنساناً رائعاً بالمعنى الذي تشير اليه وتعبر عنه سمات الانسان الرائع بدماثته وبأخلاقه وبحسه الانساني الرفيع. لم أقرأ مع الأسف رواياته. لكنني قرأت بعض مقالات وقرأت جزءاً من موسوعته التي تحمل عنوان «الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية». وهو كتاب من أربعة أجزاء يحتل مكانه في مكتبتي. غير أنني وأنا أستحضر اسم هذا الانسان النبيل لا استطيع الا ان أتساءل عن الأسباب الداخلية والخارجية التي غيرت تلك الوجهة التي كانت يعبر عنها ذلك التحول الكبير الذي أشرت إليه.
من كتاب:
وجوه مضيئة في تاريخنا
أحداث وذكريات ومواقف
كريم مروة



