الرواية بين الإمارات والكويت(4 من 4): وبدرية لــ وليد الرجيب ــ كتب: عبدالله خليفة
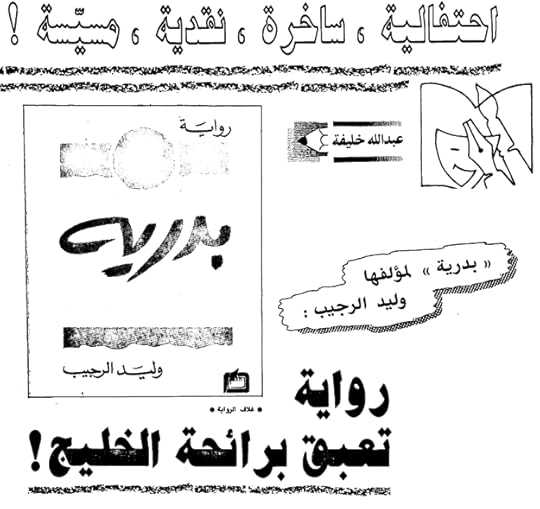
تصوغ رواية «بدرية» لمؤلفها وليد الرجيب راوياً جماعياً لعالم التحول في المدينة الخليجية، التي طلعت من عالم البحر والصحراء تواً، عبر بناء قصصي – قصير، متتابع، يعبر عن عالم التحول وصراعاته، بحيثياته الحقيقية وترميزاته المستقبلية، جامعاً بين التسجيل الفلكلوري والبناء الروائي المتقطع.
الراوي الجماعي والمحور الروائي:
يظهر الأطفال في الرواية كراو جماعي لكل الأحداث التي تقع في الرواية. ورغم أن الرواية تبدأ براو فردى، هو الروائي /المؤلف، إلا أن هذا الراوي الفردي للقصة، يسلمنا ـ بعد عبارة قصيرة ـ الى الراوي الجماعي، الذي يقودنا في احداث المدينة/ الحي وتحولاتهما الكبيرة.
أنه يقول في أول الرواية (بعد انتهاء بحثي وتحرياتي.. بعد عودتي.. بعد اثنتي عشر سنة. أمسكت بقلمي وكتبت) ص 20.
فهذا الراوي الفردي، هو المؤلف نفسه، الذي سافر الى أمريكا للدراسة، ويرجع الى مدينته ليراها قد تغيرت كلياً، وتحولت من المدينة البحرية الصغيرة الى مدينة النفط الجديدة.
وهذا الراوي الفردي، سيظهر، ليس في نهاية الرواية فقط، ليختمها بنبرة حزينة تفاؤلية، بل سيتدخل كذلك في مساعدة الراوي الطفولي الجماعي، حين لا تسعفه أدوات الفهم والتحليل، لتفسير الأحداث، أو متابعة أجزاء خافية منها.
فلدينا في الحقيقة راو واحد، هو المؤلف، الذي كان صغيراً وجزءاً من الوعي الجماعي الطفولي، ولم يكن متميزاً داخله، فيعبر، بلسان هذا الجمع الغفير من الأطفال، عن لحظات طفلية في تطور المجتمع الكويتي ـ الخليجي العربي، ثم ليتجاوز هذا الوعى الطفلي، مكتشفاً أبعاداً جديدة في الحياة، بعد أن اغتنت معرفته ـ رؤيته، وهو كبير. فهو راو محيط بكل شيء، على مستوى الماضي أو الحاضر.
هذا التباين داخل وعى الراوي، هو جزء من مرحلتين من مراحل تطور المجتمع، كان فيها التطور على ضفاف الطبيعة الاجتماعية البكر، ثم اخترق الضفاف، ليصعد فوق هذه الطبيعة.
يباغتنا الراوي الجماعي الطفولي، بحيويته، وبراءته، وسخرياته وغنائيته الشفافة. لقد روى كل لحظات الحياة الاجتماعية الطفلية، مثل ألعاب الأطفال، ليالي الأعراس، صيد البراري، ظهور السينما الخ..
إن الكورس الطفولي الجماعي هو الذي يرى هذا العالم الاجتماعي الطفولي، النابت تواً، والمتناسق الوجود، والمتناقض كذلك. فالرؤية الفنية هنا، لن تضفي طابعاً رومانسياً على تناقضات الحياة، بل سوف تبرزها، ولكن ستشكل تلك الوحدة، التألفية الشفافة في «الشعب» في تلك الحارات الفقيرة البسيطة.
ومن هنا فهذا الكورس، هو طفولة هذه الحارات، وعلاقاتها الحميمية، عندما كانت متناغمة مع بعضها البعض في رحم الوجود الطبيعي ـ الاجتماعي، الطالع من برية وبحر الخليج.
سنرى هذا الراوي وهو يروي لنا الاحداث، ويصف الشخصيات، ويشكل في رويه العفوي، قصصاً عديدة، وفي كل قصة، ثمة شخصية، هي جزء من هذا الحي الشعبي، الذي لم تغيره، بعد، تطورات المرحلة النفطية التالية.
في هذا الروى سوف يعتمد على بساطته، ولغته العفوية، الجامعة بين اللقطة التصويرية المباشرة، وتجسيد شكال الفلكلور، وصياغة الحدث الروائي المتقطع، المتصاعد.
وهو أحياناً، سيتخلى عن الطفولية، ليعود إلى وعيه الناضج، المتأخر، واصفاً الاشياء والاحداث التي تتجاوز وعى ذلك الطفل الجماعي.
خلال تفسيره اللاحق، الاجتماعي، ليدمج بين الراوي الجماعي الطفولي، والراوي الفردي .
وسنرى أن الراوي ليس هو إلا الراوي الفردي، أو الروائي، وقد لبس انفعال الطفولة وبصرها، واستعاد حيويتها ومرحها، ثم قطع هذا الانفعال، في لحظات معينة، حين احتاج المعمار الروائي، تدخلا جديدا ومختلفا وذا تحليل.
اول ما يصفه هذا الكورس، بحب غامر، هو بدرية: الشخصية المحورية في العمل والرمز.
ان «بدرية» تظهر منذ البداية، باعتبارها رمزا، فرغم سنوات الطفولة البسيطة، إلا أنها تتصرف وكأنها تجسد الحب والعدالة على هذه الارض.
فهي تكره الإنجليز المحتلين، وهي جميلة، وعذبة الحديث، ومرحة، وجريئة، ولم تخجل إلا مرة واحدة عندما سألها احدهم وصدرها يتكور «صدرك فيه حليب؟»! ص 24. وهي تساعد الجميع، فتمشط شعور البنات، وتكنس أفنية المنازل، وتشترى الحاجات للناس، وتحمل الرسائل الغرامية للشباب، سواء كانت «مكتوبة أو شفوية»، وتساعد الداية «أم شملان» في الولادات، وتقود العاب الاطفال. وتروى الحكايات بطريقة ساحرة.
لكن من أين كونت هذه الذات الرائعة؟ يخبرنا الراوي الجماعي، انها بلا والدين رسميين ووجدت هكذا في الحى: ابنة للناس. ولم يجد اهل الحى غضاضة في حياتها الطفولية الهائمة بل فتحوا لها بيوتهم وغرفهم، وصارت كابنتهم الجماعية.
تتوحد بدرية بكل ما هو جميل و«نقي» في هذا العالم الشعبي، الطيب، وكأنها تموز، وقد صار انثى، أو الزمن الربيعي الجميل السعيد، وقد تجسد فتاة. إنها تغدو صورة هذا العالم النقي، وبراءته وخضرته.
ورغم ان كل الأطفال يحبونها، إلا انها تفضل «فهدا». فهذا الفتى الصغير، الذي مات والده أثناء غرق السفينة، يساعده العامل «فلاح». لكي يعمل في شركة النفط، ليغدو هو المستقبل المنتظر لـ«بدرية».
لكن بين بدرية وفهد، يقف «بونشمى»: الرجل الغني، المقاول، الموظف اللاحق، ممثل رأس المال المتنامي ابداً في هذه المدينة البحرية المتغيرة.
ان «بونشمي» أحد المحاور الهامة في الأحداث، والمدينة، وهو الذي تتجمع في يديه خيوط الثروة والنفوذ، وقد وصفه، في البدء، الراوي الجماعي، وهو يدخل السوق، وترتفع أيدى الجميع محيية إياه، في حين استغل الراوي الجماعي الطفولي، الفرصة ليملأ جيوبه بالطماطم والخيار، ثم يقف بين يدى بونشمي وكأنه حرس محييا اياه، وتأتى «رومية» المغنية الراقصة لتحييه.
لكن هذا الراوي سرعان ما ينقطع ليظهر الراوي الفردي الحديث، بسرده الاجتماعي التحليلي، لينقب في ثروة بونشمى ومصادرها، وليصف رحلته إلى البصرة بهدف تحميل ثمن بلح النخيل الذي يملكه، وزيادة مساحة بساتينه، وزواجه من فتاة عراقية صغيرة وجلبه لصبي جديد وجميل.
لكن هذا الراوي الاجتماعي التحليلي الحديث، سرعان ما ينقطع هو الآخر، ليعود الراوي الجماعي الطفولي ويصف ذكريات الأعياد وكيف يقوم «بونشمي» بتقديم زريبة من الأضاحي لأهل الحي.
هكذا يتعاقب ويتضافر ويتقاطع الرويان المختلفان، ليشكلا بنية السرد – الوصف – الحوار، وليجسدا الأحداث والشخصيات المختلفة.
أن الراوي يقف، هنا، عند هذا المثلث الأساسي: بدرية – فهد – بونشمى. ليتغلغل في الروافد التي يشكلها هذا المثلث. ففهد حين يعمل في شركة النفط، لا يكون هناك من مقاول يجمع الانفار للشركة. سوى بونشمي ذاته. وتفلح وساطة «فلاح» لكي يتغاضى بونشمي عن سن الصغير الذي سرعان ما يتوغل في أجواء العمال المتعبة، ويعيش حياتهم البنائية القاسية.
ومن هذا المحور الروائي الدرامي، سنتعرف على شخصيات تنمو في سياقه، «كابو عيسى»، معاون بونشمي وساعده الأيمن في التوظيف والترجمة والتسجيل والمشاورة، وهندرسون مدير الشركة، والصراعات «النقابية» الأولى، وسيتسع المكان الروائي لنرى منطقة السينير الجميلة المخصصة للموظفين الإنكليز، ونرى حياة العمال الصعبة، ومجيء السينما إلى البلد، وشجار العمال والانكليز في أحد العروض السينمائية، ونلمح تأثير فلاح الفكري على فهد، ثم إبعاد فلاح عن الشركة بعد معركة الضرب في السينما التي قادها ضد الانكليز الخ..
ليس لهذا الجانب من قيمة سوى في كشف أبعاد تطور «فهد» في هذه الطبقة الجديدة التي تتشكل في المجتمع، والتي سنجد فيها امتداداً لتلك الانسجامية التآلفية القديمة للحي الشعبي. وسرعان ما ينقطع هذا الجانب من المثلث، ليظهر جانب «بونشمي».
ان بونشمى المزواج، يتعرف الى بدرية حينما جاءت تحاول إعادة فلاح المفصول والمضروب الى الشركة، فيتمعن فيها بونشمي ويشتهيها ويرغب في ضمها الى حريمه، ويتمكن من ذلك ولكن لا يستطيع أن ينام معها.
حين يحدث زواج بونشمي – بدرية، يكون ذلك فرصة مناسبة وكبيرة، للراوي الجماعي والفردي، لكي يحتفيا بهذه المظاهر الشعبية والطقس الاحتفالي الواسع، بدأ من الطبخ إلى الغناء وإلقاء الشعر.
ولا يستطيع بونشمي «أن يدخل» على بدرية، رغم محاولته للاستعانة بعيسى الذي نصحه بضرورة العودة الى الراقصة المغنية «رومية»، لكي تثير همته، لكنه وجدها عجوزا شمطاء، وبقى عاجزا، رغم تحول المدينة البحرية الصغيرة الى مدينة مالية كبيرة، يجمع هو الكثير من خيوطها في يديه، ورغم مرور العديد من السنوات على هذا الحدث. ومن جهة أخرى. فان بدرية تواصل حبها الشفاف لفهد، عبر الرسائل، الى ان يمرض بونشمى وتطلب بدرية الطلاق قبل وفاته بقليل، في وسط ترحيب وسعادة زوجاته الاخريات واولاده بهذا الطلب المتأخر. ثم تتزوج بدرية من فهد وتحمل منه، لا من بونشمى!
هذا هو المحور الروائي في الرواية أو هو الخيط الدرامي المتصاعد، القائم على صراع بونشمي – فهد، الذي يتكون عبر حلقات صغيرة، اغلبها يتركز في صراعهما الاجتماعي – العاطفي الثنائي.
لكن اذا كان الصراع الاجتماعي بينهما قد توارى بعد نمو المدينة، حيث لم يكن فهد سوى عامل صغير في شركة النفط، بينما بونشمى مالك أساسي في المدينة كلها، فإن صراعهما العاطفي حول بدرية ظل مستمرا، وبينما يفشل بونشمى في الإنجاب من بدرية ويموت مهزوماً. فإن فهدا ينجح في عملية الإخصاب «الاجتماعي».
ان هذا المحور يقوم بتجسيد الشخصيات كرموز واضحة ، فبدرية تظل هي الارض، الخصب، التي لن تكون للغنى بونشمى، وصاحب القحط الاجتماعي، بل هي من نصيب المنتجين المخصبين.
ولكونها رموزا واضحة، مباشرة، فهي لا تدخل في علاقات وتكوينات معقدة، وتظل جوانبها البارزة مسيّسة ومجسدة لهذه الاستقطابات الاجتماعية الثنائية: الفقراء – الأغنياء، الخصب – العقم، العمل – الملكية.
ويقف الراوي بوضوح ومباشرة مع الجانب الأول، واصفا قدراته القوية وبساطته واستقامته، في حين يكشف ضحالة وانانية الجانب الثاني. وهذا يقود إلى تبسيط الصراع، وادلجته، وتقسيم الشخصيات إلى ثنائية غير جدلية، دون أن تصور الصراعات العميقة فيما وراء الجانب الاقتصادي.
الراوى الجماعي والمحور الفلكلوري:
في حين يحصل المحور الروائي على ثلث الرواية، فإن المحور الثاني، المحور الفلكلوري الاحتفالي، سوف يحمل على ثلثي الرواية. فهذا المحور الاخير، سوف يتسلل الى جوانب الرواية المتعددة، ويقطع تسلسل أحداثها. ويوقف التصوير المتغلغل في شخصياتها، عارضا لوحات فلكلورية للحي وشخصياته وطقوسه واغانيه وشعره. وهذه اللوحات لن تأتي إلا في سياق المحور الروائي، وعلى ضفاف نموه، ولكنها سوف تسبب عدم تطوره.
اضافة الى الكورس الجماعي الطفولي، المعبر عن افراحه الفتية بصيد الطيور والبحث عن الفطر، واللاعب في الاعراس والليالي، والباحث عن القصص العجيبة، والمحب لبدرية، فإن هناك العديد من الشخصيات التي تظهر في سياق رويه، والتي هي جزء من عالم الحي، لا من عالم المحور الروائي رغم تقاطعها وتداخلها في سياقه.
فهناك «ابومجبل الشاوى» الراعي الذي يفتتح الرواية بمشهد غنمه، وهي تعود إلى الحي مع الغروب. ومجبل هذا لن يكون له أي دور، إلا حين يكتشف «عبادين» احدى الشخصيات الهامشية الثانوية الأخرى.
ومثله مثل «ضاوى» الجزار، الذي نجد لقطة اجتماعية عن كيفية تعامله مع البهائم المجهزة للذبح. ص 34 – 35.
وكذلك «أم نشمى» وبهائمها. ان لأم نشمي دورا في بنية المحور الروائي حيث تكون علاقة حميمية مع بدرية، لكن وجودها يتصف، بشكل عام بالسلبية والجمود. ونستغرب كيف ترى زوجها يتزوج اخريات، وهي تقف بلا حراك، بل وتشجعه حين تطلب منه أن لا يدخل على بدرية بقسوة وسرعة.
لكن هذا الوجود الروائي المضمر، يقابله وجود فلكلوري مهم، فنجد عدة صفحات تصف علاقة أم نشمي بالبهائم ص -57 -62، هي علاقة ليس لها دخل أو أثر في البنية الروائية، ولكنما مشهد فلكلوري يجسد علاقة البشر، حينئذ، بالحيوان، الذي كان جزءا حيويا من بيوتهم وعالمهم.
وهناك أيضا، (أم شملان) الحوافة، التي تقوم بدور القابلة أيضاً، كما تضع ادعية وتقوم بطقوس الزار وطرد الجن، وهي أيضا زوجة امام مسجد (ابن عويد)، وكأنها وزوجها، يمثلان البناء الأسطوري – الديني الذي يظلل المجتمع.
هذا النثر الفلكلوري لعالم المدينة، يجد تجليه أيضا في لحظات فلكلورية خاصة، مرت بالمدينة، ونموذجها حي (حولي) هنا، مثل لحظات سقوط المطر ونبت العشب، أو تحول هذا المطر الى (هدامة)، أي طوفان يهدم البيوت القديمة، ليعقبها تطور اجتماعي سريع وحاد، بإعطاء الدولة تعويضات كبيرة، واستغلال بونشمي للحدث أيضا، ويظهر الطابع الفلكلوري في عرس بونشمى حيث نشم روائح الطبخ والطيب، وليظهر الشاعران (جويعد) و(صقر ثامر).
لقد أخذ جويعد، وصقر ثامر، مشهدا قصصياً فلكلورياً، حينما راحا يتباريان شعرياً، ويقطعان تسلسل الرواية، لننتقل الى مشهد جانبي مرح وساخر.
وحتى الطبالات كان لهن مشهدهن الخاص، حيث برزت سيجارة (غازي) التي دخنتها إحداهن.
وتظهر أيضا صالحة المجنونة، في زمن اختفاء بدرية، أو زمن القحط، وهي امرأة تبيع (اليقظ والخريط والبيض) وكانت لصة سابقة، لكنها امسكت بلص جديد فاشل.
ووجدت أيضا (رومية) المغنية الراقصة، وهى الجزء الترفيهي داخل الحي، والتي دخلت الأحداث، في مقطع صغير، حينما أراد بونشمى الاستعانة بها لإثارة حميته الجنسية، ولكن هذا الإدخال لرومية، قادنا الى قصتها الكاملة، منذ ان كانت فاتنة حتى اصبحت عجوزا يتفضل عليها عشاقها السابقون بالفتات.
وحين (يتنطط) عبادين المجنون امام بونشمي صارخا عن بدرية التي سرقها بالزواج، تظهر القصة الكاملة لعبادين المجنون، وهي قصة سوف ترويها عجوز مفعمة بروح الأساطير، وعلى مدى عدة صفحات من 105 الى 111.
ويتحول حدث العدوان الثلاثي على مصر، إلى جزء احتفالي في الرواية كذلك، حين تنفجر مشاركة هذا الحي وشخصيات في الحدث، دون أن يرتبط هذا بسياق البناء الروائي.
ويتحول حدث العدوان الثلاثي على مصر. الى جزء احتفالي في الرواية كذلك، حين تنفجر مشاركة هذا الحي وشخصياته في الحدث، دون أن يرتبط هذا بسياق البناء الروائي.
وقد كان يمكن للرواية، أن تتسق أكثر لو أن بؤرتها انزاحت أكثر نحو الحي، وشخصياته، وتحول فهد وبدرية إلى شخصيتين من شخصياته العديدة المتفاعلة، كما فعل نجيب محفوظ في رواية (زقاق المدق) حين حول عباس وحميدة الى جزئيتين فنيتين في معمار الحي.
ولكن كما يحدث، عادة، في مراحل التشكيل الروائي المبكر، حين تغدو قصة الحب هيكلا ترصف فيه قصة حدث سياسي هام، أو صراعات فترة تاريخية، تغدو قصة الحب هنا، العمود الفقري لقصة كبيرة – غير منجزة بالكامل – هي قصة هذا الحى/ المدينة.
وكأن قصة الحب وضعت بقوة فوق جسد احداث طبيعية منسابة، لكنها من جهة أخرى، افتقدت الهيكل الضروري، لكى تتجمع وتشكل بنية ما.
ان لدينا محورين متداخلين متصارعين، الأول هو البناء الروائي، والذي تقع قصة بدرية في بؤرته، وهو بناء كلي، متخيل، رومانسي ثوري، وتبشيري سياسي، والثاني هو البناء الفلكلوري، الحقيقي الجزئي.
فإذا كان الأول يخط علامات التطور الأساسية في الحياة، بانقسامها بين الفقراء والاغنياء، وتراكم الثروة والسلطة في يد الأخيرين، وصراع الأولين من أجل تطوير حياتهم وحقوقهم، ويجسد هذا بالقصة الرومانسية الثورية، فإن المحور الثاني يجسد الحياة بتضاريسها الحقيقية والملموسة، بغيبيات الناس وروحهم النفعية حينا، والجياشة بالحماس القومي حينا آخر.
ولكن المحور الروائي، ذا القصة المتخيلة، وذا الطبيعة الرومانسية، يُلجم تطور المادة الواقعية الفلكلورية، عبر سيطرة (المثال الطبقي الثوري) الذي يقلل من عملية التحليل الحقيقية للحياة.
ان الرواية حين تجمع بين الجانبين، تتلمس التطور المتناقض المعقد للمدينة، بتطورها الحقيقي وأحلام مثقفيها.
وهذا يجسد منحيين فنيين مختلفين، الأول هو الروائي، حيث تتشكل شخصيات نمطية، ومحور بنائي، تنمو الشخصيات عبره، الى مسارها المرسوم في التصور الفكري، فلا يوسع هذا امتداداتها وتناقضاتها.
والثاني هو المحنى الطبيعي – النتورالي، حيث الالتقاط التفصيلي والجزئي للأحداث والشخصيات. ان هذا الجزء، حافل بالحيوية، وهو يعرض الحياة الشعبية بروح احتفالية قوية الدلالات.
تقيم الرواية امثولة جديدة لعالم الخصب/ الجدب. فبدرية، هي الترميز الواضح للقمر، للنور، للجمال هي سر حياة الحي وخصوبته. حين طلع هذا الحى تواً من عالم البحر- حيث البشر هم أطفال الطبيعة المتعاونون، وحيث الحي الشعبي قوة متضافرة، متعاونة، متجانسة.
هنا كان الخصب، والطفولة، والحب، وهنا كانت (بدرية) الترميز الجمالي لهذا العالم (النقي)، البريء والذي كانت احتمالات تطوره الخصبة كامنة فيه، حيث (فهد)، الفقير اليتيم، هو المرشح لإخصاب بدرية، أو الأرض، أو الوطن، لكن الشرير، أو الشيطان، أو الجدب، بونشمي، يظهر داخل هذا العالم، فجأة، كأنه مولود خارق داخل كيانه النظيف، فيستولى عليه، عبر أدواته القديمة، في اقتصاد الغوص، وعبر أدواته الجديدة، في اقتصاد النفط، عبر السلف، سابقاً، وعبر المقاولة والسمسرة والوظيفة حالياً، فيجدبه، وهذا الجدب له مظاهر كثيرة، مثل تمزق الحي وشجارات أهله وعداواتهم اختفاء الفرح، وأهم مظاهره هو الاستيلاء على بدرية، النور، فكأن يونشمى هو الحوتة المعاصرة التي تأكل القمر وتسل الضوء عن الوجود. ولكن البدر يُنتزع ثانية، بفضل جهود فهد، فكان العمال هم الذين يعيدون النور الى العالم، فيعود الخصب من جديد، وتحمل بدرية، مؤكدة دورة الخصب مرة أخرى، بفضل تموز العصر، أو اوزيريس، أو الدور العمالي، هذه المرة!
ورغم هذه الأسطرة فإن المؤلف لا ينساق كلية مع تجريدية الرؤية، معبئاً محتواها بتفاصيل حياتية، متلونة كثيرة، وبعملية روي مشرقة ومرحة، ولكن تبقى هذه الاسطرة للواقع، غير مستوعبة لعملية الواقع المعقدة، لتحميل بونشمي مثلا كل الشر يلغى الطابع الاجتماعي لفعله وللبناء ككل. كما يقود ذلك إلى تبسيط حركة الحياة.
ان هذه هي الرواية الاول للمؤلف، ولذا فإنها مجرد خطوة اولى في جهوده، ولا شك أنه سوف يغنيها بمادة الحياة الأكثر تلونا وغنى.



