من أفكار الجاحظ الاجتماعية والفلسفية
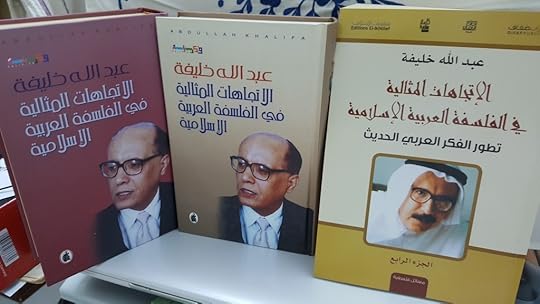 من أفكار الجاحظ الاجتماعية والفلسفية
من أفكار الجاحظ الاجتماعية والفلسفية1 ــ نقد [النابتة ] ومعناه
عبر الجاحظ عن عقلية موسوعية استطاعت أن تهضم معارف عصرها المختلفة و تدونها و تعلق عليها، في نظرة تجزيئية للمادة الثقافية العربية المختلفة الواسعة التي دونها، وفي ظل ا لمهمات الفكرية و السياسية التي و جد المعتزلة أنفسهم منساقين فيها.
فالجاحظ في كتابه [ النابتة]( 1) ، يقوم ببحث التاريخ الإسلامي عبر تحليل رموزه الشخصية فيؤكد سلامة السياق التاريخي و بتسلل الخلفاء الراشدين المعروف ، و ينقد سيطرة بني أمية على السلطة بشكل متعسف وعنيف، معتبراً معاوية رأس هذه العائلة الباغية،و يتحول نقد شخوص الدولة الأموية إلى بحث في عنفها و طغيانها، دون أن يكون ذلك جزءً من سياق اجتماعي، فتظهر العائلة الأموية كنبت شرير بلا جذور في التاريخ العربي، و ينقطع هذا التحليل و النقد عن تشكل الدولة العباسية، بل هو يظهر المنصور رأس هذه الدولة بشكل مغاير لحقيقته، فكأن تاريخ القهر والاستغلال قد أنقطع، و لهذا تبدو أراء الجاحظ السياسية كصدى لشعارات الدولة العباسية ، في الخطوط العريضة لها.
من عناوين هذه الرسالة: معاوية يحول الملك إلى كسروية ـ إدعاء معاوية الخلافة كفر ـ جرائم يزيد بن معاوية ـ مزاعم النابتة ـ تناقض النابتة ـ مخازي عبد الملك بن مروان ـ النابتة تقول بالجبر و التشبيه ـ النابتة تقول إن القرآن غير مخلوق ـ كفر النابت ـ الشعوبية و دعواها.
تمثل هذه الآراء نقداً لجماعة يسميها الجاحظ تحقيراً [النابتة]، ومن الواضح انهم من جماعة أهل الحديث التقليديين الذي أشرنا إلى صعودهم المستمر في فضاء هذا العصر، ثم يربطهم بالإمام أحمد بن حنبل، و الجاحظ يكتب رسائل عدة حول مسألة خلق القرآن ، باعتبارها ذروة العصر الصراعية ، مما يؤكد إن النابتة هم جماعة أهل الحديث.
إن الخيوط تبدو متقطعة بين الدفاع عن عصر الخلفاء الراشدين ، ثم نقد عصر بني أمية ثم الهجوم على النابتة و الدفاع عن خلق القرآن. إن المسائل مع هذا مترابطة، فالنابتة حسب تعبير الجاحظ، كانت تدافع عن معاوية بن أبي سفيان، وبالتالي كل تاريخ بني أمية السابق ، وهي النقطة الخلافية المحورية مع هذا التيار، الذي بدأ يؤكد حضوره الفكري و الاجتماعي المؤثر، وخلافاً للمنحى القدري ـ الاعتزالي الذي مثل الصعود المدني النقدي ، فإن النابتة كانوا يؤكدون العكس في مختلف خطوط الجبهة الفكرية الصراعية، فعدم سب معاوية كان يعني الدفاع عن التاريخ الإسلامي السابق بعمقه المحافظ ، و بقواه الرعوية العربية المتنفذة ، و بكل ظلال وعيها، ومستواه الاجتماعي. كما أن ذلك هو نقد من قبل أهل الحديث لهذا الصعود الحضاري المدني المتفاقم، و هو رفض أيضاً لهذا الوعي الذي يعيد إنتاج الدين على ضؤ المعطيات الجديدة، ولهذا فإن الهجوم المستمر على الدولة الأموية و رموزها من قبل العباسيين ومثقفيهم، و أبرزهم الجاحظ هنا، يتحول لدى المعارضة [اليمينية] الدينية ، إلى دفاع عن الأمويين، وسبق أن تشكل حزب يسمى الحزب السفياني يأمل بعودة الإمام السفياني المنتظر، ورافقته انتفاضات في الشام خصوصاً، ولم يكن ذلك صراعاً بين المركز العراقي الجديد و المركزي الشامي السابق فحسب، بل كان صراعاً بين هذه الأقسام السكانية المتضررة من هيمنة الأشراف العباسيين على الثروة، و لهذا فإن رجال الدين المحافظين كانوا يشعرون بأن الاعتزال يشكل بداية فقه يسحب الامتيازات من تحت أقدامهم، وهم حينئذٍ لا يستطيعون معارضة المعتزلة في دفاعهم عن الإسلام وعن حكم الخلفاء الراشدين، باستثناء السنوات الأخيرة من عهد عثمان، كما يؤكد الجاحظ نفسه، فيبحثون عن نقاط الاختلاف، فيجدونها في الدفاع عن الدولة الأموية ورموزها ، و يستجيب المثال لجانبين مهمين، والأول هو الاختلاف مع الدولة العباسية و المعتزلة وخطهم التحديثي للدين ، و الأمر الآخر وهو الظهور بمظهر الدفاع عن الناس.
و يستطيع هذا الخطاب المحافظ المتصاعد أن يهزم الدولة [التحديثية] في خاتمة المطاف ، و لكن علينا تتبع ذلك عبر المواد الصغيرة المتراكمة، ومن خلال وعي الجاحظ و عبر الأدلة التي يقدمها لنا.
فالجاحظ يقول في رسالته المعنونة باسم [خلق القرآن] ـ راجع كتاب رسائله السابق ص 165ـ [ و النابتة اليوم في التشبيه به مع الرافضة و هم دائبون في التألم من المعتزلة، عددهم كثير و نصبهم شديد و العوام معهم والحشو ..]، (2 ).
لقد أخذت المعسكرات الفكرية في الظهور وبدت النابتة هي القوة الكبيرة التي تتقدم ومعها [العوام] و[الحشو] وهي ألفاظ تحقيرية أخرى للناس هذه المرة، و تعبر عن نزعة أرستقراطية أخذت تهيمن على المعتزلة المندغمين بالطبقة الحاكمة ، ولا يناقش الجاحظ أسباب هذا الوقوف للعوام مع النابتة والرافضة. وإذا كانت [الرافضة ] مع لعن معاوية بطبيعة الحال، فإنها في التشبيه مع النابتة، وهذا الموقف المعقد و المتناقض يشير إلى الأقسام الاجتماعية العديدة التي اتفقت على معارضة الدولة من منطلقات مختلفة، كما يشير من جهة أخرى، إلى المستويات المعرفية المحدودة التي لدى الناس، والذين لا يتبعون المعتزلة بل الآخرين، رغم إنهم لا يقودونهم إلى الصواب كما يرى الجاحظ، وهو لا يتساءل ما هي قيمة لعن معاوية على حياة هؤلاء الناس، أو ما هي علاقة المفاهيم المجردة كخلق القرآن بتغيير ظروفهم، ولماذا عددهم كبير ونصبهم شديد؟!
إنه و هو يقوم بقطع قضية الخلاف عن الجذور الاجتماعية و المعرفية، يحيلها إلى مسألة مجردة . صحيح إنه يشير إلى الجوانب النفسية المتضادة لدى البشر من حسد وكراهية و ثأر في تشكيل الموقف الفكري الصراعي ، لكنه لا يقيم رابطة بين الجوانب النفسية و الفكرية و جذورها الاجتماعية، حيث إن هؤلاء العوام يبدون منساقين وراء النابتة و الرافضة بسبب الجهل المحض، و ليس بسبب انفراد الدولة بالثروة العامة المادية، و هي أيضاً تحاول الانفراد بالثروة الروحية، فتريد تشكيل الدين بصورة تتوافق مع مصالحها، في كونها دولة واسعة موحدة ، و هو الأمر الذي يشاركهم في تأييده المعتزلة ، و هذا الاحتكار للدولة للثروتين الاقتصادية و الدينية، يلغيه النمو المستمر للتعدديات المختلفة الدينية و المذهبية، فاحتكار الدولة للثروة المادية يقودها إلى تكييف الدين تكييفاً متفقاً مع ذلك الاحتكار، بحيث ترفض تعدديات الآلهة، وتقوي صورة الإله الواحد، ولكن تعدديات الآلهة بالشكل المسيحي والمانوي غدت محصورة في تجمعات بشرية محدودة، وأخذت صورة الإله الواحد تنتشر و تسود تدريجياً، نظراً للمصالح المترابطة للشعوب و الهيمنة العربية القوية في القرن الأول الهجري خاصة، ولكن مع انتشار هذه السيادة بدأت الشعوب المختلفة تبحث عن مصالحها المستقلة في إطار الوحدة الفكرية الإسلامية كذلك. ونحن في القرن الثاني الهجري لا تزال سيطرة المركز[ العراق] قوية، ولكن معارضة المركز قوية و مستمرة كذلك.
وقد وضعت المذاهب الإسلامية الأولى ركائز الوحدة، وكذلك ركائز الاختلاف أيضاً، وقد رأينا كيف عبر المذهبان المالكي و الحنفي عن مستويين اجتماعيين مختلفين للمسلمين، فالمذهب المالكي عبر عن خصائص الجزيرة العربية ببداوتها و مدنها التجارية معاً، في حين عبر المذهب الحنفي عن المصالح التجارية و المدنية بصورة أكبر، وإن لم يخرج من الإرث الرعوي، في حين كانت الجعفرية تعبيراً عن الطموح السياسي المستمر للأشراف العلويين، فهي محاولة لإبعاد العباسيين عن الحكم بدرجة أساسية، ولهذا كان صراع العباسيين والعلويين حول النور الإلهي تعبيراً عن الصراع حول الثروة المادية وامتلاكها. في حين قبل المذهبان المالكي والحنفي السيادة العباسية، خاصة مع فقهاء المذهبين التالين للمؤسسين ، والذين أخذوا يكونون البنية السياسية ـ الاجتماعية المطلقة، أي المتجذرة في الحياة بصورة ثابتة، سواء كانت الدولة عباسية أم أموية، فقد غدا هؤلاء الفقهاء هم السلطة الأيديولوجية الدائمة ، ولكن ظل مصدر الفقهاء الموالك والأحناف واحداً حيث أن النور الإلهي تجسد في القرآن والسنة وبعد هذا أنقطع وصار العقل المسلم قادراً على الاجتهاد ضمن الكليات المستخرجة، وهذا ما جعل هذا الفقه متوافقاً مع البنية السياسية العباسية المسيطرة المركزية ، لأنه يعتبر أن النور الإلهي قد أنقطع عن التراسل المباشر مع البشر بانتهاء الرسالة المحمدية، ولابد من تطبيق الأحكام حسب القرآن والسنة التي غدت منتهية، ويمكن الاستخلاص منها أو رؤية العام فيها وتطبيقه على الوقائع الجديدة، مع مراعاة المصالح العامة، مما يعني التوافق المرن مع حاجات الدول وسياساتها المتبدلة. وهذا ما جعل المذهبان الحنفي والمالكي ينتشران في رقع واسعة ، يتناغم فيها المستويان المدني(الحنفي) والرعوي (المالكي) ، أي الحضاري والبدوي، التجاري والزراعي، بتكوينات متداخلة معقدة ستشهد شيئاً من التبلور في القرن الثالث الهجري . ولهذا نجد أهل المغرب، شمال أفريقيا ، يتحولون في هذا القرن من المذهب الخارجي المعارض بشدة والمهزوم بقسوة ، إلى المذهب المالكي المتكيف مع الدولة ، ولكن الذي يعطي المغاربة هوية متميزة ، وكلا المذهبين الخارجي والمالكي نتاج الجزيرة العربية بمستواها الرعوي الغالب، وهو الأمر المقارب لسكان شمال أفريقيا.
في حين كانت الجعفرية تعبيراً عن معارضة للسلطة المركزية ، وهي في هذا القرن تنمو بشكل حثيث داخل العراق وإيران ، مما يجعلها في صراع مستمر لتفكيك الهيمنة المركزية، ولهذا تلتقي مع الطموحات القومية المتوارية،ويتشكل نسيج مشترك.
ومن هنا نرى الجاحظ وهو يحمل على من يسميهم بالرافضة، وهو تعبير حاد، ولكنه ينسجم مع ماكينة الدولة الدعائية في تحقير و انتقاص المعارضة.فهؤلاء يفككون الدولة المركزية، ولهذا فإن لديهم التأويل الخاص للصورة الإلهية، الذي يفكك الصورة السائدة عند العباسيين، مثلما يفككون جسم الدولة المركزي السياسي.
ولكن لماذا صعود [النابتة] و داخل العاصمة العباسية، مركز الحضارة و السيادة؟ أي لماذا تشكلت الحنبلية في عقر دار الخلافة؟
إن الحنبلية تقطع مع المذهبين السابقين:المالكي والحنفي، وهذا القطع غريب أن يتشكل في العاصمة،خلافاً لهذا التراكم في نمو المذاهب باتجاه التيسير و العقلنة الحضارية، فهي تقف ضد هذا التطور، و تشدد على النصوصية الحرفية المطلقة، وترفض التأويل.
لابد أن نرى المسألة كشكل معقد من التراجع والصراع والتمايز، فالهيمنة الفارسية على الخلافة العربية قد تفاقمت، ووجد الفرس و الموالي في القدرية و الاعتزال و الجعفرية و الحنفية والزيدية أشكالاً من المساواة ، وكانوا الأسبق للحضارة ، فاستطاعوا التغلغل في شتى مناحي الحياة ومراكز الدولة، في حين كانت مكانة العرب تتدهور بصورة مستمرة، و قد كانت القبائل المسلحة الغازية العربية هي التي حصلت على الثروة من البلدان المفتوحة، و لكن هذه المكانة العسكرية انخفضت و جاء الفرس، و الأتراك الآن، ولم تؤدِ تلك الثروة السابقة إلى مستويات راقية من الوعي لهذه القبائل البدوية، ولكن التدفق الرعوي العربي والتركي والكردي مازال مستمراً خاصة في العاصمة، و مناطق العراق ، و أخذ هؤلاء العرب و غيرهم يعبرون عن مستوياتهم الفكرية البسيطة بالعودة المطلقة إلى النصوص الحرفية، وبهذا كانوا يزيحون الفرس عن السيادة، وكذلك أصحاب الأديان الأخرى المهيمنين على الصرافة والتجارة كالمسيحيين و اليهود و الصابئة. إن الحنبلية تعبر عن هذا الصعود المستمر و تغير طبيعة السكان، فتشكل [هجوم] رعوي واسع النطاق من الأتراك والعرب على الهيمنة الفارسية و تحالفاتها، ولكن الانقلاب الكلي لن يتحقق الآن.
إن سكان الجزيرة العربية و بلدان الصحارى التركية والكردية و سكان شمال أفريقيا ، الذين أثخنتهم ضرائب العاصمة و الصرف المستمر على بذخ الأغنياء المرفهين، و الذين لم يكونوا يفهمون اللغة المجردة و الفلسفية لمثقفي المعتزلة المرتبطين بالقصور ، والذين لم تشكل النهضة في المركز أي تغيير ثقافي لهم، والذين كانوا يتدفقون على العمل في الجيش، إن هؤلاء كانوا ينتمون لمذهب المواجهة مع الفرس المهيمنين، ومع هذه العقلانية الثقافية ، التي لا تتحول إلى نضال اقتصادي لبلدانهم و فئاتهم المحرومة ، أي كانوا في سبيل التصدي لقرن من العقلنة الديني.



