الصوفية والتصوف
كتب : عبـــــــدالله خلــــــــيفة
لمحاتٌ صوفية
أخلى الزهدُ البسيط الذي ظهر في الفترات الإسلامية الأولى، مكانه لزهد من نوع مختلف ابتداءً من نهاية القرن الثاني الهجري، ولكن الصوفيين في تقيمهم لمسيرتهم التاريخية يقولون انهم كانوا منذ بدء الإسلام، ويضربون للتدليل على هذا بأمثلة من الصحابة كسلمان الفارسي وابى ذر الغفاري وغيرهما، وكان لابد أن يقولوا ذلك، لأن كل فرقة وجماعة وطائفة إنما ظهرت بعد قرون من الإسلام الأول، فتقوم بايجاد مكان لها في بداية التاريخ الديني، حتى لا يُقال بأنها بدعة.
وهذا التأصيل إيديولوجي.
فثمة فروق كبيرة بين الزهد الأول والصوفية، التي لم تغدُ مسلكاً تقشفياً في الحياة، بل صارت وجهات نظر فلسفية. فالصوفي لا يكرس نفسه عبر تقشف اضطر إليه اضطرارإً بحكم بساطة العيش وشظفه، بل هو يختار هذا المسلك تحدياً لطرق اجتماعية وسياسية قوية في الحياة.
فالخلفاء الذين احتكروا السلطة السياسية وفسروا الدين تفسيراً يتماشى مع استغلالهم للجمهور، استطاعوا أن يزيلوا التوجهات الدينية النقدية والمعارضة لتفردهم بالسلطة والثروة، والتي كانت شائعة في بدء الإسلام الأول وصمدت حتى القرن الثاني، رغم حملات القمع الشديدة، لكن ما بقي منها صار في ركاب الدولة، مقدماً النصوصية الشاحبة التي لا تسأل عن مال عام مفقود، وثراء فاحش وبذخ فادح.
وأخذت الفرقُ المعارضة ذاتها تنشرخ بين موالاة تنويرية للسلطة وانعزالية متقشفة كما حدث للمعتزلة، الذين أوهنتهم الضربات البوليسية والإغراءات المادية، فظهر بينهم فريق زاهد، ولكن ظل على فهمه العقلي للدين.
لهذا فإن الفهم النصوصي للدين، أخذ يعجز عن تقديم مواد لإشعال فتيل المعارضة، وقد أثمرت الرؤى الاعتزالية في دفع المثقفين الدينيين إلى البحث عن مستويات متوارية في النص القرآني، وإذا كانوا هم قد وجهوا التأويل من اجل العقل الديني، بحيث تتم تشكيل وجهات نظر موضوعية للظاهرات الطبيعية والاجتماعية، بداية للوصول إلى قوانين للوجود، فإن المتصوفة بحثوا هم كذلك عن مستويات متوارية من الدلالات القرآنية، وكل هذا لتجاوز الاحتكار النصوصي الذي استطاعت أن تتحكم به الطبقة الحاكمة بعد قرن ونصف من الإرهاب الاجتماعى.
إن انقسام الوعي الديني حينئذٍ إلى فهمين أساسيين، هما الفهم النصوصي والفهم غير النصوصي، كان يقود إلى انقسام سياسي كبير للمسلمين، فالدولة العباسية المسيطرة على إنتاج النص الديني، كانت تواجه بقوة معارضة كبيرة هي الحركة الإسماعيلية والتى سوف تقوم بشق العالم الإسلامي إلى جبهتين.
وكانت هذه الحركة قد اعتمدت نفس الأصول الفكرية الجديدة، وهي التأويل، وتجاوز النصوصية.
وبهذا فإن الصوفية ولدت في هذا المخاض الكبير، مخاض زحزحة السيطرة المركزية للنص الديني، وجعله في خدمة طبقة فاسدة، وأدوات هذه الحركة الفكرية السياسية المُضمرة، كانت أدوات في غاية البساطة ويستطيع أي مسلم، بل أي إنسان، [لأن الحركة الصوفية عالمية]، القيام بها وهي تحويل الزهد إلى رؤية فلسفية سياسية معارضة.
وصحيح إن الزهد كان موجوداًعند بعض الصحابة، لكنه لم يتضافر وأدوات فكرية جديدة، استطاع الوعي الإسلامي في ذلك المخاض السياسي، إن يدغمها والإرث الديني الخاص.
فتقوم الصوفية على تحويل الزهد إلى مواجهة للقوى المتحكمة والمستهترة بالثروة العامة. لكن هذه المواجهة ليست مواجهة مباشرة، بل غير مباشرة، لأن الصوفية لا تسيس نفسها، فلا تتحول إلى حزب أو جماعة أو حتى مظاهرة، بل هي تدمر النظام السياسي في شرايينه الداخلية الخفية.
تبدأ الصوفية بالإيمان بالله الواحد الأحد فهي بهذا تنفصلُ عن أي إرث وتراث غير إسلامي، أي عن كل الثقافة الوثنية والتعددية الدينية السابقة والراهنة، منضمة إلى الثقافة العربية الإسلامية، وبهذا فليس للحكام الساهرين على تطبيق الشريعة النصوصية أن يدمغوها بكفر أو بخروج عن الدين، وبهذا أمكن للصوفية أن تدخل النظام الاجتماعي، وتتشكل في مدنه المسيطرة، بخلاف الفرق المعارضة العنفية، التي كانت تعيش في المناطق النائية، والتي لا تقوم بتطوير العناصر المعارضة داخل المدن.
كذلك فإن هذا النمو داخل النظام الاجتماعي يتيح استثمار عناصره الثقافية المتنامية والمتراكمة، على عكس الخوارج والقرامطة، ولهذا فإن الصوفية وهي تنمو إسلامياً فإنها ستمر بمراحل أولها نظرات اجتماعية وآخرها لغة فلسفية شعرية.
لكن لا يعني هذا أن نمو الصوفية عربياً إسلامياً هو انقطاع عن الإرث الزهدي الصوفي في المنطقة والعالم، فقد عرف الشرق والمشرق خاصة، موجات متتالية من الطرق الزهدية، التي كانت هي الحل الأخير أمام تيارات من المثقفين حين لا يكون ثمة أي منفذ للخروج من الحكم الاستبدادي، كالمانوية وأشكال من المسيحية، ولن ننسى جلسة ديوجين في برميله والإسكندر يقف على رأسه، حيث يسأله: أطلب ما تشاء ايها الحكيم، فيجيب: أبعد ظلك عن شمسى!
لكن التحام الصوفية مع المنظور الإسلامي العام لا يعني بأنها ستقبل بما آلت إليه هيمنة الطبقة المتحكمة في إنتاج الدين، والتي أفرغته من مضمونه الإنساني، وحولته إلى أسلوب للسيطرة السياسية والإجتماعية، فمخاض الصوفية يدفع بالصراع مع هذه القوالب، مثلما يمنحُ من ينابيع الفلسفات الزهدية والغنوصية المنتشرة في المنطقة، لكن مع ترك أبنية الشرك والوثنية فيها.
وتشكيل منظور إسلامي، وتنحية تلك العناصر، كان يحتاج إلى زمن موضوعي، تهضم فيه العقلية العربية الإسلامية المواد الفكرية التى قاومت بها القوى الفكرية السابقة قوى الاستغلال في أزمنتها، فتستفيد من ثمارها، ولكنها ترفض منطلقاتها الخاصة، بل تأخذ عناصر معينة، هي ما يمثل الخميرة العامة الإنسانية للتصوف.
ولهذا فإن المتصوفة في مرحلتها الفلسفية المفارقة لمرحلة الزهد البسيط السابقة، يبدأون بإعادة تفسير المنظومة الإسلامية في جانبها الاجتماعي بدرجة أساسية في المرحلة الأولى.
ففى هذه المرحلة لا يتمايزون عن بقية المسلمين في اتباع الفرائض والعبادات وصنوف التكاليف الشرعية، غير أنهم يبدأون بطرح مفاهيمهم الخاصة، وأهمها محبة الله، فإذا كان الفهم السائد هو عبادة الله، فالمحبة أشمل وأوسع من العبودية، فهي تغيير نوعي في العلاقة بين الخالق والمخلوق، يتغير فيها الكثير من العلائق بين الطرفين، وبالتالي فإن المفهوم يفتح بداية صفحة جديدة للوعي الدينى، من لغة المفارقة إلى لغة المشاركة.
وقد حفر في مفهوم المحبة أوائلُ الزهاد كرابعة العدوية، وبهذا فإن الوعي الصوفي الإسلامي المتوجه للحب الإلهي، جعل فكرة المحبة بؤرة لتطوره الفلسفي، فالمريد الصوفي المتوجه لمحبة الله، أخذ يشكل المفاهيم الداخلة في نسج هذه العلاقة المحورية الكلية عند الصوفيين.
إن أهم المفاهيم المحورية التي تصنف هذه العلاقة هي مفهوما المقامات والأحوال، فالمقام هو تعبير عن الانجذاب المستمر نحو الله، والذي تكرسه خصائص معينة لدى المريد، هي الزهد والرضا والورع والصبر، وهي صفات عميقة أساسية بدونها لا تترسخ حالة المريد، فهي كما يقولون صفات لازبة.
في حين أن الأحوال هي صفات عارضة، وتعكس هذه الثنائية صراع الصوفي بين مثله في الانفصال عن الواقع، والالتحام النفسي بالخالق، والتي لا تشكلها سوى قسمات جوهرية في روحه، في حين أن الأحوال تعكس علاقاته بالحياة وتغيراتها وظروفها اليومية من مرض وصحة وزواج وعمل الخ. . إنه الصراع بين السماء كمفهوم غيبي والأرض مفهوم واقعي.
وهذا ما يعبر عنه كذلك مفهوما القبض والبسط، فالقبض انشداد الروح للخالق والبسط توجهها إلى العارض والعادي.
إن الصوفية ليست طريقة روحية للذوبان في الملكوت الإلهي فحسب، ولكنها صراع سياسي في المدن الإسلامية السابقة، التي لم تتح للصراع الاجتماعي طرق التبلور الديمقراطية.
فالصوفيون يقومون بخلق طريقة مضادة للأنظمة بإزالة التملك، وهو عمودها الفقري للبقاء. فرفض الصوفية للتملك وانتشار هذه العملية بين الجمهور، هو أمر سوف يكرس رموزاً مغايرة للحكام والأغنياء المسيطرين على المدن.
إن رفض التعامل مع السلطة والتجار ورفض الرقيق والجواري وتعدد الزوجات الخ..ن كأن يؤدي إلى تشكيل تيار عام ضد أشكال الاستغلال المختلفة.
رأت امرأة من الصوفية الوزير علي بن عيسى وهو يسير في موكب ضخم فسألت من يكون هذا المهيب الجليل وكانت تعرفه فقالت: هذا رجل سقط من عين الله فابتلاه بما ترون !] مدارات صوفية، هادي العلوي، ص 33.
وقد نسب الصوفية عن أحمد بن حنبل إنه حرم الغزْل (النسج) في مشاغل السلطان!
وقد دعا الصوفية إلى إشاعة الأملاك، وأسموه تسبيلاً، ومنه ماء السبيل. وفى ذلك يقول المعري:
ففرق مالك الجمَّ وخلّ الأرض تسبيلا
وقد انتقلت الصوفية بعد انتشار مفاهيمها من النقد الاجتماعي الموارب الى النقد الديني، فأصبحت التكاليف الشرعية ليست هي جوهر الدين في رأيهم، فهذا البسطامي، من كبار المتصوفة، كان يعتزم الحج، فطلب منه فقيران يتصدق عليه فأعطاه كل ما يملك وعاد إلى بيته.
وهذا ما بدأ يفرق صوفية الشطحات والفلسفة عن صوفية العبادات، ولكن مثل هذا النقد والرفض لم يكن يقود إلى تحولات عميقة في المجتمع, فالآراء الصوفية توجهت للغيب، وعبر العلاقة معه، والذوبان فيه، كانت تشكل نقداً اجتماعياً غامضاً، فتغدو المذاهب الصوفية من حلول ووحدة وجود، موجهة للغيب، وليس لتحليل الواقع، وبهذا فإنها لم تكن قادرة على فهم المجتمع وتشكيل علاقات نضالية مع الجمهور، ولهذا فإن الأفكار النقدية تتواجد في كومة هائلة من الغربة الدينية، كذلك فإن الأبنية النظرية الغامضة كانت تتحول إلى أشكال عبادية جديدة، ويبهت ذلك المضمون المتردي الذي طرحته، لافتقاده إلى علاقة جدلية مع الواقع والناس.
كذلك فإن تغيير بعض المفاهيم الدينية وبقاء الأسس الموضوعية لتطور المجتمع على ما هي عليه، من استغلال سلطة وفئات وسطى تابعة لها، ومجتمع زراعي حرفي متخلف، كان يؤدي إلى تحول الصوفية نفسها، وقد عجزت عن التطور الفكري والسياسي، إلى دروشة وأشكال كاريكاتيرية تنشر التخلف والشعوذة.
ان كافة المحاولات التي بذلت للتغلب على الاستغلال في العصر الوسيط كانت ترتكز على ضعف تطوره الإنتاجي، وهي ضد تشكيلته الإقطاعية السائدة وضد الرأسمالية المضمرة، وللبقاء في عالم متقشف بسيط كسبيل لتجاوز التناقضات الاجتماعية، ولكن ذلك مستحيل.
ولا يعني ذلك إغفال هذا التراث النقدي، ولكن يجب رؤيته في ظروفه وإمكانياته التاريخية.
إن اللمحات المعادية للاستغلال والقهر ترتبط هنا بكتل ضخمة من الغياب عن الواقع، وبخلق اغترابات جديدة، وصلات موهومة، كما أنها تلغي الإمكانيات الكبيرة للسعادة والتمتع في هذه الحياة.
ملاحظات حول تطور الصوفية
هناك مسافة زمنية وفكرية واجتماعية بين عملية البروز الأولي للصوفية، وبين بروز من عرفوا بـ«الأقطاب» كعبدالقادر الجيلي (الكيلاني) والبسطامي والجنيد والحلاج وابن عربي.
إن كثيراً من الدراسات لا تقوم بربط هذا الصعود المستمر لوعي الصوفية، بتطور الأزمة في الدولة العباسية، من الجانب الجغرافي، حيث راحت الدولة في هذا الصعود الصوفي تتمزق وتتحول إلى دولة مدينة، كما أنها من الناحية السياسية كانت تتحول إلى عاصمة روحية، يحكمها ويخلق الاضطرابات فيها تحكم قبائل من شرق آسيا، ويواجه العامة فيها فقراً متزايداً مدقعاً بعد نضوب الإيرادات المجلوبة من الولايات، كما أن ارادة هذه العامة تتصاعد وتقوى بأشكال مختلفة.
ومن هنا فإن التبلور الصوفي للأقطاب الكبار: البسطامي/ الحلاج / الجيلي، تم على ضوء هذه الأزمة، وبالتالي فقد كانت الدولة تواجه إمكانيات تحول سياسية لم تتحقق، سواء بالهجمات المستمرة من قبل القرامطة، أو بثورات العامة وصعود روابط الفتوة.
ولهذا فعلينا أن نربط خيوط الأزمة السياسية والأزمة الفكرية المتصاعدة كذلك، بحيث إن النصوصية التي ارتكزت عليها الدولة العباسية، عبر بعض المذاهب السنية، لم تستطع أن تخلق استقراراً سياسياً، بل ان فرقة سنية متشددة هي الحنبلية انتقلت للعمل السياسي والاجتماعي ضد الدولة بقوة، ومن داخل المدينة العاصمة في هذا الزمن.
إن تطور الصوفية نحو الفلسفة كان يجري كعمليات تعميم فكرية باتجاه نزع الشرعية الدينية المسيطرة على جهاز الدولة العباسية، وتنامت هذه العملية بعد أن استطاع الصوفيون تكوين روابط اجتماعية كبيرة داخل المدينة.
لكن ما هى علاقات الترابط والتداخل بين نمو الصوفية فلسفياً ونمو الأزمة السياسية اجتماعياً، وهل استطاع الصوفيون أن يبلوروا الأزمة علي صعيد الوعي السياسي، أم أن الوعي الصوفي لم يسعفهم في ذلك وما هي الأسباب التكوينية الفكرية الداخلية التي حالت دون ذلك؟
إن أحداً من الباحثين لم يقم بتحليل هذه الأبنية الفكرية والاجتماعية والسياسية المتداخلة، لكنهم يقدمون لنا مواد مهمة في سبيل الوصول إلى ذلك.
وهل هناك فروق موضوعية بين الصوفيتين الاجتماعية والفلسفية، وهل المذاهب الشرعية يمكن أن تؤسس كيانات خاصة داخل الاتجاهات الصوفية؟
إن كل هذه الأسئلة لا يمكن الإجابة عنها دون معرفة كيان الصوفية الفكري، الذي يمثل جوهرها الاجتماعى.
قلبُ الرؤية الصوفية يقوم على أن النفس كانت جزءا من العالم العلوي الروحي الإلهي، وقد هبطت إلى الأرض وصارت داخل كيان المادة، فحجبتها حجب كثيفة عن عالمها الأصلي، وهي لا تستطيع أن تتحرر من قيد المادة الجسمية إلا بمجاهدات روحية صعبة، تؤدي إلي إطلاق الروح الفردية من سجنها والتحاقها بالروح الكلية، وسمِ أشكالَ هذين التحرر والوصول ما شئت من أسماء، وسم درجات التحرر ومجاهداته وألوانَه ومحطاته، ما شئت من أسماء، فالفكرة الأساسية واحدة.
إن الروح المأسورة داخل الجسد، هي الحقيقة الوحيدة في عالم الصوفية، وما المادة وأشكالها سوى أوهام خبيثة سيطرت على الروح، وهكذا فإن الصوفية تطيحُ بقوانين العالم الموضوعي؛ عالم الطبيعة والمجتمع والوعي، فهذه ليست أشياء موضوعية متدرجة ذات تطور طويل كما هى متشكلة، بل هي وهم في نظرها، وكي تلغي الروح هذا الوهم وتتحد بأصلها العلوي، عليها أن تدمر هذا الوهم الذي يبدأ بالجسد ويتصل بالطبيعة والمجتمع.
إن هذا الموقفاً الأساسي الذي يسمُ كلَّ اتجاهات الصوفية وهو لب فلسفتها، يجعل اتجاهاتها عبر التاريخ والجغرافيا السياسية والدينية متماثلة، فحين يطيح الوعي هنا بقوانين المادة الموضوعية، يغدو ذا تشكيلة واحدة، فإذا كان المجتمع وهما، فلن يعد المجتمع ذا تاريخ موضوعى، ومراحل، وكذلك تغدو الطبيعة غير متموضعة وذات سيرورة، أنها تغدو وهماً، وبالتالي فإن الروح المأسورة داخل الجسد الوهمي، تستطيع أن تتحرر منه، وتذهب بعيداً، وتصل إلى الروح الكلية، أو تنفصل عنه، ويبقى الجسد حياً، فلا يعد للجسد قوانين موضوعية، فهو إناء عابر للروح.
إذا كانت مشكلة فهم الروح تتصل بالوعي الديني عموماً، الذي لم يستطع أن يحل ألغاز علاقات الجسد بالوعي، وهو ما يشكل جذور المدارس المثالية فلسفياً، فإن الصوفية تطلق هذا التناقض بين الجسد والروح، إلى أقصى مداه.
وبما أن كل دين يغدو شكلا لتجلي الروح حسب الوعي الصوفي، فإن ليس ثمة فروقٌ بين أشكال الوعي الديني المختلفة، سواءً كانت وثنية أم بوذية أم مسيحية أم يهودية أم إسلاماً. إن الروح الموحدة تفيضُ بألوانها المتماثلة جوهراً، كذلك ليس ثمة فروق بين لحظات تطور الدين الواحد، فكل هذه اللحظات درجات من تحور الروح.
إن التكوين الموضوعي للدين بوصفه حركة فكرية واجتماعية معينة، لا قيمة له صوفياً، ومن هنا نجد أن مراحل ومدارس ومذاهب الصوفية قد تلاشت مع إيمان الصوفية بهذا المبدأ الروحي الكلي.
فإلغاؤها للفروق بين الأديان أولى بأن ينطبق على اتجاهاتها.
ووجودُ جوهر مطلق في الأديان، وبالتالي في النصوص الدينية المختلفة، وتوحد البوذية والوثنية والمسيحية والإسلام في ذلك الجوهر الروحي المفارق للمجتمعات، (لأن هذه المجتمعات هي وهم)، لهذا فأبنية الأديان من دور عبادة وشعائر ومناسبات تصير وهماً كذلك.
فلا تغدو هناك دراسات لتنوع الأديان واتجاهاتها وعصورها، ولتعبيرها عن مراحل وقوى مختلفة، بل تصير جوهراً واحداً مقارقاً لـ(إنائه) الاجتماعي الوهمي.
ولهذا فإن الصوفي حين يلغي الأشكال الوهمية التي سجنت الروح، ويتحرر من أسر المادة الطبيعية والاجتماعية والفكرية، يقتربُ بمقاربات معينة من الله، وهذه المقاربات رغم تنوع أسمائها، فإن جوهرها واحدٌ، فالحلولُ والفيض والاتحاد، ما هي إلا بمثابة تنويعات على علاقات الروح الكلية بالروح الجزئية البشرية؛ طرق التقاءاتها وكم اتحادها.
فمادامت الروح موحدة في انفصالاتها فهي أولى بالتماثل في اتحادها.
ولكن هنا ثمة فروقا بين الروح البشرية الملموسة الفردية، وذات العلائق والشروط الاجتماعية الخاصة، والروح الكلية الخارجية، النائية، هي علاقة الخاص بالعام، والجزئي بالكلي، والملموس بالمجرد، والمرئي بالغيبي. إنها علاقة التوتر وعدم إمكانية التحقق والوحدة، فهذا الاتحاد لا يتم إلا على صعيد الوعي الذاتي للصوفي. ولكن في سبيله هو يلغي كلَّ شيءٍ خارجي وعامٍ واجتماعي وطبيعي وفكري موضوعي واجتماعي، في سبيل الوصول.
لكن ومع تغييبها القوانين الموضوعية للطبيعة والمجتمع والوعي، كيف تستطيع الصوفية أن تؤثر في المجتمع وتناضل داخله؟
فكيف يستطيع الصوفيون وقد انسحبوا لتكاياهم وذواتهم المنفصلة عن المجتمع أن يشكلوا تأثيرا تحويلياً فيه ؟
إن الصوفية وهي في مهمة توحيد الأديان، أي توحيد الروح الإنسانية في مواجهة عالم المادة والأنظمة، تقوم هي الأخرى بزيادة تفاقم تقسيم عالم الإنسان الروحي والاجتماعي. وتلك المفارقة تكشف حقلاً كبيراً من التضادات.
نستطيع أن نحدد نشأة الصوفية حين أخذ هذا الوعيُ الديني يُطبق محتواه الفكري، أي حين أصبحت الصوفية واعية لمنهجها ولذاتها، حين أصبحت تنفصل عن أشكال الوعي الأخرى.
فحين انعزل إبراهيم بن أدهم (٧٧٧م) وهو أمير بلخ بخراسان في المسجد بعد أن ترك ملكه ونبذ أمواله، مكتفياً بـ(القليل من الطعام، ويواصل القراءة والصلاة، ويعمل في الوقت نفسه على دعوة الناس إلى نبذ الدنيا، والتوافر على الصلاة)، أعلام الفلسفة العربية، ص ٢٧١، فإننا لا نعد هذا صوفية، فهذا زهد إسلامي، بدلالة المكان. مثله مثل حسن البصري، أو هاشم الكوفي (٧٧٦)، وهذا الأخير كان يرتدي الصوف تقشفاً، ويلازم المسجد في الكوفة،(المصدر السابق، نفس الصفحة).
يقوم الصوفيون بالانسلاخ عن المسجد، مثلما سيعيدون تأويل القرآن؛ أي أنهم سيشكلون دور العبادة الخاصة بهم، وأشكال هذه العبادة المميزة، والقراءات الخاصة بهم للقرآن. وما رافقها وتلاها من إدخال الطرب والرقص في العملية الدينية، أي أنهم سيعيدون النظر في الإرث الدينى الخاص بهم، ليصنعوا الطرق الصوفية.
إن موجات الزهد كانت تحلق في الأقاليم، وحين تغلغلت في العاصمة بغداد انعطفت نوعياً. فظهورُ الأقطاب فيها، هو مركزة للتراث الديني والصوفي خاصة، فالمركز أعاد تشكيل المواد الزهدية الإقليمية وحولها إلى فلسفة، إلى الصوفية بذاتها.
علينا أن نرى في المركز قدرة الصهر الفكرية والاجتماعية، فالزهد هنا لا يقابل بالتضاد الكلي مع الدولة الباذخة الجبارة فقط، بل هو يتمازج مع كل الإرث الفكري والفلسفي للفرق والاتجاهات العريقة، فالزهد الاعتزالي كان موجوداً بقوة، لكنه لم يتحول إلى صوفية، ولهذا فإن طريقة إبراهيم أدهم في العزلة ولبسه الصوف والتخلي عن ثروته، ودخول هذه الطريقة إلى بغداد، يضع علامات خارجية كلبس الصوف وعلامات اجتماعية كالتخلي عن الثروة، ولكنه بعدُ لا يجعلها رؤية صوفية، إن هذا الزهد يخلق فقط القواعد الاجتماعية والبشرية لتشكلها الفكري العميق.
لكن مع يزيد البسطامي يتغير الموقف، يتحول الزهد إلى رؤية صوفية، أي أن رؤية الروح كقوة مفارقة للمادة، وقادرة على التغلب على سجونها التنظيمية والعبادية المختلفة، هي عملية الانعطاف التي جعلت من الزهدية الاجتماعية ذات الوعي الفكري المحدود فلسفةً صوفية.
ولهذا فإن وجود هذه الأقطاب المتلاحقة: البسطامي/ الجنيد/ الكيلانى/ الحلاج وغيرهم في بغداد، ليس مصادفة أو تراكماً اعتباطياً، بل هو عملية الصهر الفلسفية التي أقامتها العاصمة في المواد الزهدية والإرثية الإسلامية والعالمية السابقة، لتجعلها فلسفة صوفية إسلامية.
وعلينا أن ننظر كيف أن موجات المعارضة الفكرية والسياسية من الزيدية حتى الإسماعيلية لم تستطع أن تضع موطئ قدم في العاصمة، على مدى قرون، في حين أن المعارضة الصوفية قد تبلورت في العاصمة تحديداً، الأمر الذي يوضح الانهيار الداخلي العميق في السلطة السياسية، وكذلك غموض وصعوبة هذا الشكل من المعارضة الفكرية الصوفية.
فالتحول النوعي للأفكار الزهدية السابقة أخذ يتوجه لتفكيك العقيدة بثوابتها التقليدية، أي أن معارضته توجهت ليس لتحليل الوضع الاجتماعى القائم ونقده، بل الى تجاوز الشريعة كما كونتها الأجيال السابقة. فالتجاوز الصوفي بدلاً من أن يقوم بتوحيد الجمهور المشتت في مواجهة السلطة، حسب منطلقاته الأساسية في وحدانية الروح الدينية، قام بخلق انقسامات جديدة، عبر تركيز خطاباته الفكرية على إعادة رؤية العقيدة الإسلامية، مثل إعادة النظر في رؤية الإله، والشعائر كالحج والصلاة الخ.. فالاتصال المباشر بالإله، وإعادة النظر في كل الموروث الديني، يحول الأقطاب الصوفيين إلى أولياء، بيدهم السلطة الروحية، التي تسلب من السلطتين السياسية والروحية التقليديتين، نظامهما الفكري الروحى السائد.
مثلما يقول أبويزيد البسطامي فقد سأله أحدهم: «بلغني أنك تمشي على الماء وفي الهواء وتأتي إلى مكة حين الأذان وتركع وترجع فرد عليه:
المؤمن الجيد هو الذي تجيئه مكة وتطوف حوله وترجع»، مدارات صوفية ، ص57. فروح القطب هي مركز الكون الفكري الذي يشكله، وبياناتها هي لغتها الشعرية، التى تقوم بهدم المنطق الشكلي، فتوحد الأضداد غير المتوحدة في مثل هذا المنطق، كالأرض والسماء، والله والمؤمن، وشكل الشريعة ومضمونها.
فهى لغة شعرية تلغي المسافات المكانية بين المؤمن ومقدسه، بين الإنسان والكائنات من حوله، بين العصور المختلفة، بين الأنبياء والأولياء، وتستهدف توزيع الثروة المادية على البشر، عبر جعل القطب الولى، مركز السلطة الجديدة غير الحاكمة، نموذجاً جديداً للحاكم، الذي يتخلى عن الملكية المادية، ويكوّن حوله أتباعاً ومريدين بلا قصور وحراس.
إن االقطب الصوفي كسلطة سياسية وروحية يشكل سلطته الشعبية، فالطريقة الصوفية تصير لها مراتب، حيث القيادة هي القطب، ثم تتدرج من تحته المراكز الدنيا، من المتدارك فالمجذوب ثم السلك وأخيراً المريد. فإضافة إلى نموها الروحي الداخلي الذي يعكس مدى ذوبان العضو في الطريقة، والتزامه بإرادتها، فهي كذلك تتوجه للانتشار الجماهيري عبر خلق الهيكل التنظيمي واستقطابه للناس.
إن كل هذه الأمور تحضر للمعارك التي ستخوضها الصوفية، ولكن أية معارك وبأي نجاح؟
لذلك حديث آخر.
الصوفيون والثورة
بعد أن اصبح الصوفيون قوة في عاصمة الخلافة بغداد، غدت مسألة تغيير الحياة السياسية مطروحة، ولكن كيف تتبدى الثورة في تلك الأنظمة الفكرية الغامضة الملغزة ؟
لا نستطيع أن نفصل تطور الصوفية في العاصمة وخراسان عن تطورها في مصر وبقية العالم الإسلامي في القرن الثاني الهجري، فما كان يطرحه ذوالنون المصري من تنظير صوفي هو جزء من التراكمات التي كانت تؤدي إلى تحول الزهد الإسلامي إلى فلسفة صوفية.
ولننظر أولاً إلى ان تبلور الصوفية جرى في العالم العربي الإسلامي الزراعي الشمالي، حيث غادر إنتاج الوعي الديني الإسلامي المناطق الرعوية، وبدأت الأقطار العربية الإسلامية المتحضرة القديمة تستعيد موروثاتها، فذوالنون يقوم بمخاطبة الآثار المصرية القديمة، والسهروردي الذي سيأتي في القرن السادس الهجري سيدخل النار المجوسية كقوة نورانية في عالم الأنوار الذي شيده كمنظومة، وهذا الرجوع الذي يحفر في الموروث القديم، يتشكل داخل الأطر الإسلامية التي تنهار تحت مفرداته التي تتماهى فقط مع الموروث الغنوصي والصوفي في العصور السابقة والبلدان المختلفة.
وكما استخدمت شعوب الهلال الخصيب ومصر الأفلاطونية والأفلاطونية المحدثة كوسيلة لمقاومة الغزاة البدو سواء كإغريق (مقدونيين) أو كرومان، فإنها سوف تستخدم الصوفية ضد العرب البدو، حيث الإله المفارق في تصورهم.
إن استعادة الموروث القديم وتطورات الفلسفات الصوفية سيكون ضمن الأطر الإسلامية التي راحت تهتز ثم تتلاشى مع تطور الفلسفة الصوفية.
فهكذا يتحول الزهد إلى ما يشبه الإضراب الدائم عن الطعام، وربما عن الزواج والعيال والفرح، وهذا الموقف المضاد للإسلام باعتباره دينا يحث على الخيرات والمتع السابقة، يجعل المتصوف يناقض المظلة الفكرية والاجتماعية السائدة، ويشكل مثلاً وبنية فكرية مختلفة.
إن المتصوفة ليسوا من أفراد الشعب العامل والبسيط الذين اعتادوا الجوع، بل هم أفراد انسلخوا من الفئات الوسطى الميسورة عموماً، ولهذا يحاولون عبر هذه العملية المتطرفة، التي تتجاوز حتى شظف الفقراء وبؤس المساكين، أن يقدموا أنفسهم كأبطال وكرموز لهؤلاء الفقراء.
لكن هذه الرمزية البطولية التي تنمو عبر الانفصال عن الأرث المادي؛ كالتخلص من القصور والبيوت والمال، لا تتشكل عبر علاقة مفاهيمية محددة، كأن يطرحوا برنامجاً لتغيير أحوال الفقراء أو تبديل النظام الاجتماعي، بل انهم يقدمون البرنامج عبر ذواتهم، عبر أحوالهم، ومعاناتهم وبتخلصهم من الرفاه، بل إنهم يرون أن طرح أي برنامج لتغيير الحياة المادية هو سقوط في أوحال المادة، أو أن أي تحليل للظروف المعيشية أو السياسية هو الوقوع في ذات الشبكة.
فلكون الروح هي الخلاص فإن هذا الفصيل الجديد من أبناء الفئات الوسطى، يقول إنه ينبغي على الداخلين أو المتأثرين بهذا النهج أن يتحرروا لا من السلطات أو الأوضاع العامة، بل أن يتخلصوا من الأكل والشراب والمتع وأن يجاهدوا داخل أرواحهم، فتغدو المعركة روحية لا اجتماعية خارجية.
ولهذا فإن الرابطة الصوفية التي تتشكل على مثل هذا الوعي لا تتكون من وعي برؤية الأرض المحيطة وبالتضاريس المادية والجغرافية والاجتماعية، أي أن الصوفي لن يرى قريته وهي تتدمر من إقطاع أو من قحط، أو أن ثمة طرقاً لتحويل المياه إليها أو أن ثمة سبلاً لتطوير أشكال الزراعة، فكل هذا وهم مادي، فهو يقوم بالانفصال عن العالم الخارجي بكل تكويناته الموضوعية، إلا من الدين، وله طريقة خاصة في هدمه.
وإن الصوفي في مجاهداته لإذلال الجسد المادي الذي هو زنزانة الروح، يتحول إلى بطل ورمز للإنسان البسيط الذي يرى هذا المثقف الميسور الحال، وهو يقوم بالتغلب على الشهوات كافة وروح البذخ والتنعم، متحولاً إلى حارس على بستان، أو حرفي معدم، مما يقود إلى أفق إزالة التبعية التي تشكلها الفئات الوسطى للقصور والأشراف على مدى التاريخ الإسلامي والشرقي عامة، كما يحدسون . ولكن هل يستطيعون ذلك ؟
يصبح انسلاخ الصوفي عن فئاته الوسطى، متجهاً لهدم سلطة الأشراف الذين يقوم عالمهم على البذخ وهدر الثروة العامة، لكن هذا الهدم هو أمر غير مباشر، هو عملية تفكيك طويلة المدى، مع انتشار الطريقة الصوفية.
كما أنه هو هدم أيضاً للبناء الديني الرسمي الذي صار جزءا من عالم البذخ هذا، فكيف يقوم هذا الصوفي الذي يشبه القمامة البشرية بهدم الإمبراطوريات السياسية والدينية ؟
إن علينا أن نرى كيف أن الزهاد المتحولين إلى متصوفة كانوا يتحدثون بعبارات ليس فيها خرق للمفاهيم الإسلامية كقول رابعة العدوية (١٨٥ هـ): «إلهي أنارت النجوم، ونامت العيون، وغلقت الملوك أبوابها، وخلا كل حبيب إلى حبيبه، وهنا مقامي بين يديك…»
أو ما يقوله معروف الكرخي (2٠٠ هـ) : «ليس الشأن في أكل الشعير ولا لباس الصوف والشعر. الشأن في المعرفة، وأن تعبد الله ولا تشرك به» .
إن إشارات رابعة والكرخي إلى التعبد والعشق والمعرفة بالإله، تظل تحت إطار المظلة الدينية السائدة، وإن هذه الكلمات التي تُقال أثناء مخاض سقوط العصر العباسي الأول، الذي عبر عن هيمنة سلطة مركزية كاسحة، تترافق معه طبيعة هذه الكلمات المحدودة، التي بعدُ لا نلمح فيها لدى الصوفيين شطحات ما، مما يعبر عن هذا التغلغل الصوفي في المدن المهمة بهدوء، على العكس من زمن الأقطاب التالين في ذات العاصمة، التي تمتلئ بهذه الشطحات بعد مرور نصف قرن أو يزيد.
وفي هذه الأثناء كان التفكك السياسي للدولة قد حصل، بانحصار الملك العباسي في العاصمة وما جاورها، ومجيء البويهيين الذين حولوا الخلفاء إلى ألعوبة في أيديهم، وعبر النمو الصوفي من جهة وتضعضع الدولة ورمزها الخليفة من جهة
أخرى، كانت الصوفية تتنامى، كشبكات تمتلئ بالمريدين، وكوعي يغرف من شتى الفلسفات المترجمة، وينهل من الأدب العربي خاصة الشعر منه، فيتحول في ذاته، أي هذا الوعي الصوفي، إلى سلطة.
اما البناء الديني الفكري للدولة فهو يتزعزع كذلك، فلا نعرف هل هى دولة سنية أم إمامية، ولكن المسائل الأعمق من ذلك تتمثل في أن الدين كما تكرس رسمياً عبر قرنين وأكثر لم يقم بالإجابات عن المشكلات العميقة للسكان، خاصة انتشار الفقر وتحكم استغلال الأشراف وحدوث الاضطرابات والحروب والكوارث المختلفة، فلا بد والحالة هذه من رفض هذه المسيرة الرسمية للدين كما تكرس من قبل المذاهب والفرق المختلفة المتصارعة.
إن الصوفية النامية في حضن الدولة والثقافة الإسلامية تتوجه هنا إلى استكشاف الخريطة الإسلامية العامة والبحث عن سبل للوصول إلى حلول للأزمة، فيتجلى الطريق لرابعة عبر الحب الإلهي، وعند معروف الكرخي من خلال البحث عن معرفة، أي أن هذه البذور الفكرية سوف تتشكل على أرضية الرفض للخلافة ومؤسساتها وضد البنية الثقافية الدينية المتشكلة عبر القرنين السابقين التي أوصلت المسلمين إلى وضعهم الممزق والمنهار حينذاك.
وهذا لا يتشكل إلا من خلال مناخ العزلة الصوفية، التي تفترض حتماً الانقطاع عن المخلوقات والفرار منها إلى الخالق، وهذه العزلة تقود إلى تدمير العالم الموضوعي الخارجي المحيط بالصوفي، فهو في جوعه ومجاهداته المستمرة المؤلمة، الذي يخضع ويذل فيها جسده، يزيح مرئيات وعلاقات العالم الخارجي، مركزاً على عالمه الروحي الداخلي، الذي يحاول الاتصال بالله، وهذا ما يقود إلى تقطع روابط الوعي بالعالم، مما يقود بالضرورة إلى تضخم هذا الوعي الذاتي، وتحوله إلى المحور لذاته، أي أن الصوفي وهو يدمر الخارج يعلي الداخل، فهو إن يلغي السلطات والأشياء والناس، يحول ذاته إلى سلطة مطلقة.
إن إلغاء الصوفية للعالم الخارجي والسلطة والناس لا يتشكل دفعة واحدة، فهذه علاقة اجتماعية تاريخية، تنمو بشكل متدرج، فرغم عدم اعترافه بالخارج، فلا يعني انه يستطيع التهرب من العلاقات الموضوعية لتشكل وعيه والعالم المحيط به.
فهي علاقة تتكون مع نمو أزمة النظام الاجتماعي، فنمو الطرق الصوفية يتشكل مع ترنح وتدهور أشكال الوعي الأخرى، أي عدم قدرة تلك الأشكال على مجابهة أسئلة المرحلة والتصدي لعمليات الانهيار السياسي والاجتماعي.
فعجز الاعتزال في مرحلتيه الماضية والراهنة عن القيام بدور العقل الإصلاحي الفاعل، وتبعية مذاهب أهل السنة للدول المسيطرة؛ وعجز المعارضة الإسماعيلية عن طرح بديل يطور وضع المسلمين، إن كل هذه المسائل المتشابكة، ليست أسئلة عقلية فحسب، بل هى أيضاً علاقات اجتماعيه وسياسية تأخذ زمنا تاريخياً لتتكشف للجمهور وللوعي المثقف.
فتدهور مقولات المعتزلة وأهل السنة الفكرية وعجزها عن تقديم حلول للأزمة المستفحلة، داخل العاصمة والنظام الاجتماعي السائد، يجعل الصوفية تصعد إجاباتها وتطرح بديلها داخل النظام وفي عاصمته المهيمنة المتدهورة، يحدوها في ذلك نموها المتدرج وفي غلالة من الغموض العبادي والفكري.
كما أن عجز الإسماعيلية التي صورت نفسها كبديل للخلافة العباسية وبقدرتها على حل معضلات التطور وغياب العدل، تقع هي نفسها في معضلات التطور وفي العجز عن إنتاج «العدل» .
وهذا ما يقود على مستوى التطور داخل النظام العباسي المحدود، أو خارجه في عمليات الإسماعيلية لطرح البديل عبر الدوله الفاطمية أو غيرها، إلى أن يكون البديل الصوفي ليس مسألة مشرقية، أي ليست خاصة بأهل المشرق الإسلامي، بل تغدو كذلك مسألة مغاربية أيضاً.
لأن ذات الأسئلة التي تؤرق الحركات الاجتماعية داخل أطر وعيها الدينية؛ تعاني منها الأوضاع في الأندلس وشمال أفريقيا كذلك. فتصير العملية إسلامية عامة، فيصب المغاربة مساهماتهم الصوفية عبر ابن عربي وابن طفيل وغيرهما.
ومن هنا يقوم المشرق العربي الإسلامي، وهو مركز الحضارات القديمة ووريثها، بإنتاج وتوزيع ثمار العمليات المركبة بين الماضي البعيد والحاضر، بين الأقاليم المختلفة المعاصرة وقتذاك، في مخاض تقطع أوصال الامبراطورية الإسلامية، فهي تنهار عملياً ويقوم الوعي الصوفي المنتفخ بتصعيدها إلى الغيبيات في أقصى انقطاعها عن العقل والأزمة الموضوعية.
هكذا تتجلى المرحلة التي نصفها في عقر دار الخلافة، فصورة الله التي كرستها الحضارة الأرستقراطية في تجلييها المعتزلي والسني، حيث كانت الأولى تجعل هذه الصورة عقلاً محضاً، وتستكشف سببيات تشكل العالم الموضوعي، ولكن ليس فى امتداده الاجتماعي، وفي تجليات التطور الاسلامي المتعدد الطبقات والصراعات، بل في سببيات طبيعية منقطعة عن الأزمة الاجتماعية.
في حين أن صورة الله التي تقدمها المذاهب السنية بصفته المتدخل في الوجود بشكل كلي، ومستمر، فإن هذه الصورة تناقض التدهور الحاصل للمسلمين وسوء حياتهم الخ..
أما الصورة التي تقدمها المذاهب الإماميه عن الله فهي صورة تراتبية تجعل مع الله أئمة، مع تداخل الاعتزال العقلي ومع رؤية أهل السنة في هذه الصورة كذلك.
أي أن المتصوفة يتقدمون لتقديم صورة مختلفة عن الله في تضاد كلي مع هذه الصور المعقدة أو المفارقة، متصورين بأنها حل لجميع هذه التناقضات. لكن من خلال عزله كلية عن الدخول في التاريخ!
وإذا كانت الصور التي تقدمها المذاهب والفرق هي انعكاس لعلاقاتها بالسلطات والناس، عبر التطور التاريخي السابق والراهن، فإن الصوفيين يقومون بتقديم هذه الصورة من خلال انسحابهم من هذه العلاقات بالسلطات والناس وبالتطور التاريخى، ملغين التراتبية والمفارقة وحصائلها وحصالاتها المادية من كنوز أرضية وضرائب على ظهور الفلاحين..
راجع كل ذلك في كتاب : الاتجاهات المثالية في الفلسفة العربية الإسلامية، الجزء الثالث، وهو يتناول تشكل الفلسفة العربية عند أبرز ممثليها من الفارابي حتى ابن رشد 2005.
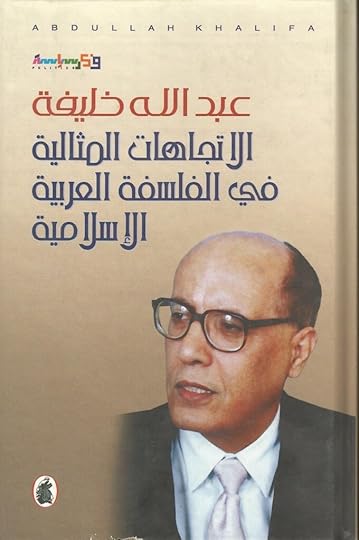 __ATA.cmd.push(function() { __ATA.initDynamicSlot({ id: 'atatags-26942-6369cd2129bf6', location: 120, formFactor: '001', label: { text: 'الإعلانات', }, creative: { reportAd: { text: 'الإبلاغ عن هذا الإعلان', }, privacySettings: { text: 'الخصوصية', onClick: function() { window.__tcfapi && window.__tcfapi( 'showUi' ); }, } } }); });
__ATA.cmd.push(function() { __ATA.initDynamicSlot({ id: 'atatags-26942-6369cd2129bf6', location: 120, formFactor: '001', label: { text: 'الإعلانات', }, creative: { reportAd: { text: 'الإبلاغ عن هذا الإعلان', }, privacySettings: { text: 'الخصوصية', onClick: function() { window.__tcfapi && window.__tcfapi( 'showUi' ); }, } } }); });



