مراحل تطور (البرجوازيات) العربية : عبـــــــدالله خلــــــــيفة
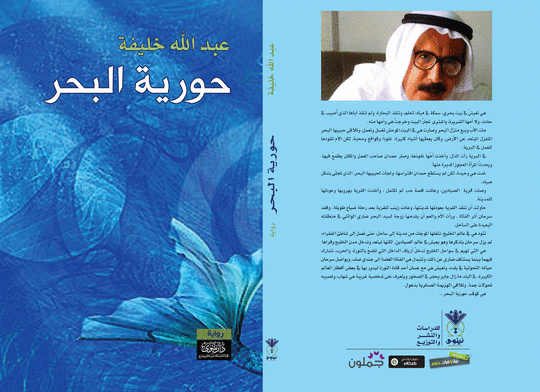 مراحل تطور (البرجوازيات) العربية
مراحل تطور (البرجوازيات) العربيةحدثت تعميمات لدى الباحثين العرب تجاه الفئات المتوسطة، عبر سلق تعبير (الطبقة البرجوازية)، فالفئات المتوسطة في العصر العربي الكلاسيكي، كانت في حالة تبعية شبه كلية للإقطاع، في حين إن في الزمن المعاصر تتشكل في حالات متعددة تبعاً للتبعية أو الإنسلاخ من الإقطاع.
عند العديد من المفكرين والباحثين المعاصرين هناك التعميم، وسواء كان ذلك في الفكر الفلسفي كما عند مهدي عامل، أو كان في التأريخ الثقافي كما عند الدكتور سيد النساج في مصر في دراساته عن القصة القصيرة المصرية خاصة.
لا بد من تحقيب قراءة الفئات الوسطى، بمعنى أن نعرف إن لها حقباً، مرتبطة بتطور قوى الإنتاج وعلاقاته.
في الفترة الحديثة الأولى كانت مرتبطة بالاستيراد، ولهذا كنا نقرأ لمفكريها شطحات نهوضية كبيرة، فشبلي شميل أو إسماعيل مظهر وسلامة موسى يدعون لحداثة غربية ناجزة، وهي حداثة التاجر المستورد، الذي لم يشكل قوى إنتاج صناعية عربية، والذي يحولُ النهضةَ إلى استجلاب للبضائع الفكرية ويعتقد إنها تحلُ إشكال التخلف. إنها مرحلة رأس المال التجاري.
في البحرين نجد ذلك يتقارب مع فترة مثقفي هيئة الاتحاد الوطني، رغم إن استيرادهم كان أقل تطوراً من قرنائهم العرب بطبيعة الحال.
في الفترة الثانية والتي حدثت في البلدان العربية (المتطورة) حين لم يعد الاستيراد هو العلامة الميزة للإنتاج والوعي الطليعي، هنا حدث الانتقال من الاستيراد الكلي إلى الاستيراد الجزئي ونشوء بدايات التصنيع، والذي أرتكز على المرحلة السابقة، وزمن الحربين العالميتين اللتين ساعدتا على إستنهاض كوامن الإنتاج، وفي هذا الزمن استطاع الفكر عبر طه حسين وأحمد أمين ومن ثم حسين مروة وغيرهم على إنتاج قراءات عربية إسلامية. إنها مرحلة رأس المال الصناعي الخاص – العام الأولي.
إن الفترتين السالفتي الذكر شكلتا ما نسميه بالنهضة الوطنية والتقدمية، رغم إن الكم النقدي ليس بمستوى الفترة الثالثة، لكن كان هذا الكم النقدي يتجه في كثير منه إلى قواعد الصناعة، ويمكن أن ندخل في حساب ذلك الأنظمة الوطنية التي تشكلت والتي وسعت الصناعات، وهي كلها فترة وجهت النظر العقلي نحو نقد الواقع والتراث، بمستويات متعددة ومقاربات مختلفة.
ثم جاءت المرحلة الثالثة الراهنة والتي اعتمدت على فورة صناعات الاستخراج، وخاصة النفطي منه، وهي مرحلة إعادت الإستيراد بقوة، سواء على مستوى الإستيراد من الغرب، أو إلى مستوى الاستيراد من الماضي العربي.
وهي صناعة إستخراج لا تغير جذور المجتمع السحرية والأمية لكنها تتنج مردوداً مالياً كبيراً.
ولم تعتمد على تطوير قواعد الإنتاج السابقة، بل أدت في العديد من البلدان إلى تحطيمها، كتصفية الصناعات الشعبية، أو تخريب الصناعات المؤممة، أو نقل المصانع الخربة الملوثة من أوربا الخ.. وهذه كلها أدت إلى صعود الطفيليات الإدارية الكبرى التي أفسدت الثقافة.
هنا نجد الوفرة النقدية في بعض البلدان لم تؤد إلى نهضة، إلا بشكل إستيراد الكماليات بصورة بذخية مدمرة.
الاستيراد الجديد هو الذي شكل الجماعات المذهبية السياسية، التي راحت تجتر ما قاله القدماء الجامدين في فهم الدين. إن الوفرة المالية هنا ساعدت على اعتقال العقل، في حين كان زهد طه حسين أو سلامة موسى أو حسين مروة أو جمال عبدالناصر أوعبدالكريم قاسم مشابهاً للتراكم النقدي المطلوب لدى برجوازية التصنيع الأولي وتقشفها.
إن المراحل التالية التي قد تستمر في الماضي أو قد تصححه، مرهونة بمدى تعزز مواقع القوى الديمقراطية في المجتمعات العربية، ومدى تحويل صناعات الإستخراج والصناعات الخفيفة إلى صناعات كبرى، وتغيير الهياكل السكانية المتخلفة.
والمرحلة الثالثة نجد تجلياتها الفكرية في النقل الآلي من الغرب والنقل الميكانيكي من التراث، وضخامة الاستيراد على الجانبين، فهنا راقصة مغنية بأحدث موضة وهناك مقنعة تخاطب القبور، شكلان متضادان يعبران عن أن القوى الشعبية لم تتمكن من السيطرة على الموارد وجعلها من إجل الإنتاج العربي.
لا بد من رؤية حلقات التداخل بين المراحل العربية الثلاث التي أسست النهضة منذ القرن التاسع عشر الميلادي.
لقد كانت مرحلة رأس المال الخاص والعام متداخلة، فهذان الرأسمالان الموظفان في الصناعة الخاصة والعامة، تصادما في المستوى السياسي، فكان صناعيو المرحلة التي وقعت فيها الانقلابات العسكرية يرفضون المشاركة في دعم الإنتاج، خوفاً من دعم هذه الأنظمة التي بدا فيها الواقع السياسي مقلقاً وخطراً على التوظيفات الرأسمالية.
إن عدم دعم الصناعيين لخطط التنمية التي طرحتها الحكومات العسكرية، بدا لهذه الحكومات العسكرية الوطنية بمثابة تآمر وحصار، ومشاركة في الموقف الاستعماري الرافض للتصنيع.
لكن الحكومات العسكرية من جهةٍ أخرى لم تعِ بأن التصنيع غير مرفوض غربياً لكن المرفوض هو التصنيع بيد الحكومات العسكرية، فهذا كانت له نتائجه الحربية والسياسية على خريطة المنطقة، ولو أن العسكريين سلموا السلطة لحكومات منتخبة لما كان الأمر كذلك.
وهكذا فإن التصنيع العام الذي ظهر بيد الحكومات العسكرية كان يمثل قطيعة مع التصنيع الخاص الذي تشكل بيد الرأسماليين الأفراد والشركات والبنوك الخاصة، واحتلال الحكومات للفضاء الاقتصادي كان من شأنه أن يرعب الرأسمال الخاص الجبان بطبيعته، وهذا ما أدى على المستوى الفكري إلى نهجين متضادين كلياً، فهناك الشعار الاشتراكي الحكومي، وهو بمثابة غطاء لفشل التعاون بين البرجوازية الحرة وبين الفئات الوسطى الحاكمة العسكرية، وهو بمثابة رد وإلغاء لدور هذه البرجوازية التاريخي، فتم إعدام وجودها من الثقافة والتاريخ، ولم يعد ثمة من فكر سوى فكر الاشتراكية الحكومية التي صُورت على إنها نهاية التاريخ الطبقي.
إن عدم القدرة على تشكيل تعاون بين هذين الرأسمالين كان يعني توقيف نمو بذور الوعي الديمقراطي العربي والإسلامي المنتج، وهو الوعي التحرري الموضوعي، الذي طلع بشق النفس، ولكن أدوات التحليل لديه لم تتطور ولم تتجذر، فظل نائياً عن الجدل وفهم تناقضات التطور الموضوعية.
فكان الجانب الثاني من الوعي المعبر عن الرأسمال الخاص، قد تعرض للتآكل فنرى طه حسين والعقاد وأحمد أمين وغيرهم يتوقفون عن درس ونقد الواقع، بينما كان الفكر الماركسي العربي يتوه في زفة الاشتراكية الحكومية، ويفقد أدوات التحليل بشكل آخر، فيذوب ذيلياً في هيمنة القطاع العام الدكتاتورية، والتي في تصوره كما في تصور العسكر، تلغي وتزيل الطبقات!
إن الفكرين الوطنيين المعبرين عن رأس المال العام والخاص، تصادما وعجزا عن التعاون، مثلما أن المصنع الخاص الصغير تعرض للإنهيار من العملقة الحكومية، والتي توجهت لهدم التصنيع الخاص، وترك الأشكال الأخرى كتجارة الجملة والمفرق والعقار والصرافة تعيش مؤكدة سيطرة الجوانب الطفيلية من الاقتصاد على الجوانب المنتجة.
وهكذا فإن الإنتاج على مستوى الصناعة وعلى مستوى الوعي، تعرضا للتآكل التدريجي، فالصناعة الخاصة تعرضت للحصار، والصناعة العامة تعرضت لسرقات البيروقراطية الحكومية المتنفذة، في حين كان الوعي الوطني الديمقراطي بمختلف أجنحته يتعرض هو الآخر للتآكل، لأنه هدم التصنيع الخاص الحر وأوقف النظر التحليلي الموضوعي في رؤية الاقتصاد، وراح يشكل قصوراً في الهواء.
إن القفزة التصنيعية الكبيرة كان لها نتائج هامة وعظيمة، وقد مثلت نقلة أخرى في دعم القاعدة الاقتصادية، لكن غياب الحرية والنقد ومجيء المشروعات بالقوة من الأعلى، وعدم ترابط التصنيع مع تغيير الريف، وانفصام ذلك كله عن تغيير الثقافة الشعبية والأسرة الأبوية، هذا كله أدى إلى توقف التصنيع العام عن دوره الثوري الواعد.
وعبرت الهزائم العسكرية وعدم القدرة على تغيير خريطة المنطقة لصالح الاستقلال العربي، عن عجز القطاع العام بصيغته البيروقراطية غير الديمقراطية، عن تشكيل النهضة والتحكم في المصير، فعاد القطاع الخاص للسيادة مع صراع شديد ضد العام، ومع تدخلات مالية أجنبية وطفيلية هائلة.



