سلطان العامر's Blog, page 3
October 31, 2015
ما هي علاقة التحريض الطائفي بعمليات داعش؟
من يطرح هذا الطرح؟
كلما قامت داعش بعملية في السعودية، يقوم فريقان في السعودية بترديد الحجة التالية: (التحريض الطائفي هو السبب المؤدي لهذه العمليات). التياران اللذان يتبنيان هذه الحجة هما:
١- التيار اللبرالي السعودي.
٢- التيار الشيرازي الشيعي.
التيار الأول المعروف، أما التيار الثاني- باختصار- أقصد به تيار منتشر في القطيف مكوّن من أعضاء سابقين في الحركة الشيرازية الرسالية تبنوا بعد عودتهم من المنفى خطابا طائفيا* (علمانيا تارة، ودينيا تارة أخرى) سلميا يحاول حلّ “مشكلة الشيعة” (أنا لا أؤمن بوجود مشكلة سياسية خاصة بالشيعة) من داخل الدولة وليس عبر التصادم معها. رموز هذا التيار تشمل توفيق السيف، حسن الصفار، جعفر الشايب، ومن الشباب نجد هناك وليد سليس.
أمثلة على من يطرح هذا الطرح؟
عبدالرحمن اللاحم (نموذج تقليدي للبرالي السعودي) كتب مقالة بعنوان (ما زلنا نجزّ العشب) يذكر فيها أن علينا بدل أن نجز العشب الذي ينبت بين فينة وأخرى، أن نقوم باقتلاع أصل النبتة الخبيثة، وهي هنا “ثقافة الغلو والتكفير والتطرف وملاحقة المحرضين على الفتنة وتقديمهم للعدالة كشركاء في تلك الجرائم…إلخ” (لاحظ أن هذا يعتبر محاميا، وانظر كيف يسيء استخدام معنى التحريض القانوني لأغراض ايديولوجية).
حسن الصفار إسلامي معروف وأحد رموز الشيرازية، ذكر في خطبة الجمعة الماضية كيف أن التوصيفات الدينية المسيئة لأهل البيت باتت تمنح الغطاء والمبرر للاعتداءات الارهابية. رغم أن الأخير لم يقصر الأمر على الخطاب الديني، إلا أن الإثنين يعتبران الخطاب التحريضي سببا.
ما هو التفسير المطروح؟
لننظر مرة أخرى في التفسير المطروح: الخطاب التحريضي هو سبب العنف. ما المقصود بهذا الكلام؟ المقصود أن هناك خطاب ما يجعل الأفراد أكثر جاهزية للقيام بعمليات عنف ضد الشيعة. أي أن أمامنا هنا سلوك محدد: شخص يقوم بتفجير نفسه في حسينية، والتفسير المطروح لهذا السلوك هو تواجد نوع من الخطاب والأفكار والثقافة. أي أن هذه الحجة تقول أن الثقافة (س) هي السبب في السلوك (ص).
ما هي هذه الثقافة؟
الجواب غير معروف. فهناك من يقتصرها على خطاب مشايخ الصحوة الطائفيين، وهناك من يوسعها لتشمل خطاب الصحوة، وخطاب المؤسسة الدينية الرسمية، والتعليم، والإعلام، والمواد التي تدرس في الجامعات. هناك من يقصرها على الصحوة والخطاب الإسلامي الحركي، وهناك من يحمّل الوهابية ككل مسؤولية هذا التحريض. لا يوجد تعريف محدد وواضح حول ماهية ثقافة التحريض هذه، وأعتقد أن هذا الغموض في حد ذاته كاف لرفض الأطروحة (لأننا لا يمكن أن نجعل سبب ظاهرة ما غامضا، التفسير بالغموض مثل عدم التفسير) من أساسها وكشف بعدها السياسي باعتبارها وسيلة موجهة ضد الخصوم السياسيين. لكن سنتابع الحديث لأن هناك فعلا من هو مقتنع بهذا الموضوع بدون كثير تأمل.
هذه التدوينة مخصصة لمن يجعل الخطاب التحريضيسببا للعمليات التفجيرية.
أي أن الذي يعتبره أحد الشروط، أو أحد الظروف، أو يعتبره سببا من بين مجموعة كبيرة من الأسباب، ليس معنيا هنا. المعني هنا هو من يعتبر الخطاب التحريضي السبب الوحيد أو السبب الرئيسي أو السبب المهيمن لأعمال العنف التي تقوم بها داعش.
لماذا هذا الطرح خاطئ؟
١- هناك فرق بين (الإقتران) و(السببية)
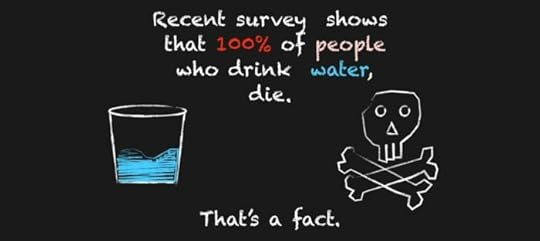
عندما أرجع كل يوم إلى المنزل، اسمع كلبا ينبح في الشقة المجاورة لشقتي. عندنا هنا عاملين: ١- نباح الكلب. ٢- عودتي للمنزل. هذان العاملين حدوثهما مقترن، كل ما حدث (العودة للمنزل) حدث (نباح الكلب). هل نستطيع القول أن عودتي للمنزل هي سبب نباح الكلب؟ الجواب: لا. هذا اسمه اقتران، والاقتران لا يقتضي السببية. وهذا صحيح، فأنا أعود للمنزل كل يوم في الساعة الثانية، وفي الساعة الثانية هو موعد أكل الكلب فينبح طلبا للأكل. فسبب نباحه لا علاقة بينه وبين عودتي للمنزل، واقترانهما إنما هو بسبب أن كلاهما يحدثان في الساعة الثانية.
قد يعترض شخص على هذا التفسير ويصر على أن عودتي للمنزل هي سبب نباح الكلب. هنا، استطيع أن أثبت له تفسيري بطريقة بسيطة: أن أتأخر في العودة ساعة. أي أن أغير من أحد العوامل وهنا لا تزول السببية فقط، بل يزول الاقتران نفسه.
فكون من قام بالتفجيرات في السعودية تأثروا (بخطاب التحريض)، فهذا لا يجعل خطاب التحريض سببا للقيام بالتفجيرات. كل ما يمكن قوله هو أن هناك (اقتران) بين خطاب التحريض والقيام بالتفجيرات، مثلما أن هناك (اقتران) بين كون الإنتحاريين ذكور، وسعوديين ومسلمين. هل نقول أن (الذكورة) سبب للعمليات التفجيرية؟ أو نقول أن (الجنسية السعودية) سبب للقيام بالتفجيرات؟ أو أن (الإسلام) هو سببها؟
٢- كيف يتحول (الإقتران) إلى (سببية)؟
ليس من السهل أن نقول أن علاقة اقتران ما هي علاقة سببية، لا يكتفي مجرد ملاحظة الاقتران للوصول إلى أن هناك علاقة سببية، يجب القيام بعدة خطوات طويلة حتى نستطيع أن نغلب الظنّ أن هناك علاقة سببية.
سنأخذ المثال التالي: كلما ضغطت على زر في الجدار، سمعت صوت جرس. هناك علاقة اقتران بين (ضغط الزر) وبين (صوت الجرس). لكن هل ضغطي للزر هو سبب سماعي لصوت الجرس؟ حتى نصل لهذه النتيجة لابد من القيام بالخطوات التالية:
أ- التكرار. كلما تكررت العلاقة بين ضغط الزر وسماع الجرس، فإن الاحتمالية تزداد بأن هناك علاقة سببية بينهما.
ب- التعاقب. كلما كان حدوث (سماع الجرس) يأتي بعد (ضغط الزر) في كل مرة، فهذا يزيد احتمالية وجود علاقة سببية بينهما.
ج- خلو العوامل الأخرى. كلما حدث الاقتران مع تغير كافة العوامل الأخرى، كلما زاد الاحتمال أن العلاقة سببية. يعني مثلا ضغطنا الزر في النهار وفي الليل، في الشتاء وفي الصيف، ضغطته أنا وضغطته أنت. بهذي الطريقة نفينا عامل أن الاقتران بسبب الوقت، أو بسبب الحرارة، أو بسبب الضاغط نفسه. وجربنا كافة التفسيرات الاخرى وفي كل مرة نكتشف ان عملية الاقتران موجودة، بهذه الطريقة تزداد الاحتمالية أن العلاقة سببية.
د- وجود رابطة سببية بين السبب والنتيجة. مثل أن الزر مربوط بالجسر بسلك كهربائي، وكلما ضغطنا على الزر يرن الجرس. هذه الرابطة ممكنة منطقيا، ويمكن اختبارها، وليست غرائبية أو عجائبية.
هناك قائمة طويلة للطرق التي نحاول التأكد من خلالها أن الاقتران عبارة عن علاقة سببية غير هذه، لكن هذه مجرد أمثلة فقط.
لننتقل الآن للإقتران بين (الخطاب التحريضي والعمليات الإنتحارية):
١- التكرار. هذا غير متحقق. ليس كل متأثر بالخطاب يقوم بعملية انتحارية ضد الشيعة. هناك متأثرين به ضد العمليات، هناك متأثرين به من رجال الأمن يحمون الشيعة، هناك متأثرين به يكرهون الشيعة لكن لا يؤيدون قتلهم، هناك متأثرين بهمع قتل الشيعة في مكان لكن ضده في مكان. إذن هناك أكثر من اقتران وليس اقتران واحد:
الاقتران الأول: اقتران بين المتأثرين بالخطاب والعمليات الانتحارية ضد شيعة السعودية.
الاقتران الثاني:اقتران بين المتأثرين بالخطاب ورفض العمليات الانتحارية ضد شيعة السعودية.
فكيف تكون واحدة (سبب)، والثانية (ليست سبب)؟ لا بد من تفسير لكل من يقول بهذا الأمر.
قد يقول المدافع عن هذا الرأي، أن كلما زاد تأثر المتلقي بالخطاب، كلما كان احتمالية قيامه بالعملية أكثر. وهذا ما يفسر الاختلاف بين المتأثرين. هذا تفسير جيّد، لكن ليس لدينا أدوات قياس: كيف نقيس مدى تأثر الشخص بالخطاب؟ كيف نعرف أن المفجر كان متأثرا بالخطاب أكثر من أخيه؟ هذه المعلومات لا نملكها، وبالتالي الاستناد عليها لا معنى له.
٢- التعاقب، وهذا متحقق. كل من فجر ضد الشيعة في السعودية كان وهابيا قبل قيامه بالتفجير.
٣- الإتساق: وهذا يعني أن العلاقة متسقة. فكلما زاد السبب تزود النتيجة، وكلما قلّ السبب تقل النتيجة. مثال: كلما زدت حرارة النار، فالماء يغلي بسرعة أعلى، وكلما قللتها فإن الماء يغلي بسرعة أقل.
هل هذا متحقق في الخطاب التحريضي والعمليات الانتحارية؟ الجواب: لا. فهذا الخطاب كان في الثمانينات أيام عزّ الصحوة الإسلامية في السعودية مرتفعا بشكل كبير، ولكننا لم نرى أي عمليات انتحارية ضد الشيعة. ولكنه الآن عندما قلّ بشكل كبير عما كان عليه قبل ثلاثين سنة، نجد عمليات انتحار. هذا يضعف احتمالية وجود علاقة سببية بينهما.
٣- خلو العوامل الأخرى. وهذا غير متحقق. فمن فجر في الشيعة في السعودية هم: ١- متأثرين بالخطاب التحريضي. ٢- ذكور. ٣- سعوديين. ٣- شباب. ٤- مساجين سابقين، أو لهم أقارب مساجين. ٥- مبايعين لداعش. ٦- مسلمين. وغيرها الكثير من العوامل المشتركة. فكيف نستطيع أن نقول أن أحد هذه العوامل فقط هو (السبب)؟
٤- وجود رابطة سببية بين السبب والنتيجة. فأصحاب تفسير (الوهابية هي السبب)، يقولون أن الخطاب التحريضي يزيد من معدلات الكراهية والجهل والحقد والضغينة في المتلقي، وهذا يدفعه لفقدان عقله ورحمته وضميره، ويصبح مستعدا للقيام بأي شيء ضد المخالفين له، كقتلهم. هذا تفسير يبدو منطقيا للوهلة الأولى، ولكنه مبني على مسلمات كثيرة لا يوجد دليل عليها:
أ- أن الخطاب يؤثر على السلوك بشكل كبير. وهذا ليس صحيحا، انظر هذه المقالة لبدر الراشد يستعرض فيها النظريات التي تتحدث عن العلاقة بين الخطاب والسلوك.
ب- أن المنفذين مدفوعين بالحقد والكراهية والجهل والضغينة. وهذا لا يتناسب مع شكل العمليات، فهذه عمليات مصممة بدم بارد، ومختارة بعناية، وواضح الغايات السياسية منها. فلو كانت الكراهية والضغينة والجهل هي الدافع وراء العمل، لقام الجاني بقتل أي شيعي في الشارع، أو يذهب للعراق ويقتل من الشيعة ما يشاء. لماذا اختار قتل هؤلاء الشيعة بالذات، في هذا المسجد أو الحسينية بالذات، في هذا الوقت بالذات؟ هذا يعني أن العمل مختار بعناية، وبدم بارد، وضمن حسبة عقلية هادئة.
هذا يجعل من الرابطة المقترحة بين السبب والنتيجة غير مقنعة.
إذا لم يكن التحريض، فما هو السبب؟
هذه مغالطة أيضا. قد لا نعرف ما هو السبب، لكن هذا لا يعني أن نقبل أي تفسير. والهدف من هذه التدوينة ليس توضيح السبب، بل توجيه النقد للخطاب التحريضي باعتباره سببا. وسبب هذا النقد هو:
١- أن هناك من يستخدم هذه العلاقة السببية لتمرير أجندة سياسية.
٢- أن هذه العلاقة السببية خاطئة، وقد يقود تبنيها والعمل بناء عليها إلى إنفاق الأموال والجهود
والوقت على أمر خاطئ.
٣- أن جانبا من الأجندة السياسية المقترحة المستغلة لهذه العلاقة تهدف إلى تضييق الحريات والخطاب الإعلامي أكثر مما هو ضيّق. وهذا قد نفكّر به بأنه امر مقبول في حالة طوارئ أو حرجة، لكن بناء على تحليل خاطئ؟ ما الذي يدعونا للقبول به.
٤- سبب شخصي بحت: أن هناك الكثير من الغباء خلف تبني هذا الطرح، وأنا صراحة يستفزني الغباء.
طائفي هنا ليس بمعنى نشر الكراهية والحقد بين المذاهب، بل بالمعنى السياسي، وهذه محاضرة قمت بإلقائها في ديوانية العوهلي حول مفهوم الطائفية .
November 24, 2014
ميسا ومقاطعة إسرائيل ودار مدارك
ميسا ليس اسم فتاة، وعلاقة مدارك بها تحتاج لأن أبدأ القصة من بدايتها.
ميسا هو اختصار لاسم جمعية دراسات الشرق الأوسط (Middle East Studies Association). تأسست هذه الجمعية عام ١٩٦٦م، ومقرها الرئيسي في ولاية آريزونا، ويتجاوز عدد أعضاءها الـ٢٦٠٠ عضو غالبيتهم أكاديميين ومتخصصين في دراسات الشرق الأوسط. وفي كل عام، تقيم ميسا اجتماعها السنوي الذي يضم العديد من الندوات الأكاديمية والنقاشات المفتوحة حول الشرق الأوسط، كما أنها تقيم الاجتماع الخاص بأعضائها.
في هذه السنة، كان الاجتماع في العاصمة الأميركية واشنطن، وكانت القضية الرئيسية التي شغلت اجتماع الاعضاء هو موقف ميسا من حملة مقاطعة إسرائيل الأكاديمية (BDS). في يوم الأحد ٢٣ نوڤمبر ٢٠١٤، عقد الاجتماع الأولي لمناقشه لأخذ موضوع المقاطعة بالاعتبار والمناقشة فيه. حضر هذا الاجتماع مئات الأكاذيميين، وكان النقاش فيه حامي الوطيس بين المؤيدين لطرح موضوع المقاطعة للنقاش وبين المعارضين.
ما هي علاقة دار مدارك بكل هذا؟
دار مدارك لمن لا يعرفها هي دار إماراتية مملوكة لدى الإعلامي السعودي تركي الدخيل، وقبل عدة أشهر، قامت بترجمة كتاب لمؤلف صهيوني اسمه جوشوا تيتلباوم. عنوان الكتاب “السعودية والمشهد الاستراتيجي الجديد“، يدعو فيه الكاتب لنوع من التحالف بين الكيان الصهيوني والسعودية. في تلك الأثناء قام مجموعة من المغردين العروبيين في السعودية بشن حملة تويترية ضد الدار تحت هاشتاق (#تطبيع_دار_مدارك)، كما قام صلاح الحيدر بتقديم بلاغ ضد الدار لدى اتحاد الناشرين العرب، كما أنه نشر مقال في الأخبار بعنوان دليلكم إلى تركي الدخيل.
لنعد الآن إلى ميسا.
جوشوا تيتلباوم كان حاضرا في الإجتماع، وبينما كان الأكاديميون المؤيديون لمقاطعة اسرائيل يقدمون العديد من الحجج لصالح الحملة، قام هو رافعا الكتاب الذي ترجمه تركي الدخيل قائلا: أنتم تدعون أن العرب يعادون اسرائيل، ها هي دار مملوكة لسعوديين قامت بنشر ترجمة لكتابي، ليس كل العرب مثلكم، ليسوا كلهم يريدون مقاطعة اسرائيل!
كانت لحظة سوداء، بل كان شعورا مؤلما بالتضاؤل والعار. بعدها على الفور بدأت بالتفكير: ما الذي يدفع مدارك بالإقدام على هذه الخطوة دون أن تخشى عواقب هذه الفعلة؟ الجواب: أنها تفترض أن أرباحها ستظل كما هي مع هذه الخطوة، وأن السعوديين سيستمرون بالشراء منها رغم أنها تترجم للصهاينة وتبث دعايتهم. ففكرت بأنه من الضروري أن نبيّن- كعرب وسعوديين بشكل خاص- بشكل صريح أننا نرفض مثل هذه الخطوة.
هناك الكثير مما يمكن عمله ازاء هذا الموضوع، فعلى سبيل المثال يمكن طرح هذه الفكرة كمقترح عمل: مقاطعة دار مدارك في معرض الكتاب القادم في الرياض بعد أربعة أشهر. هدف المقاطعة: ١- قيام الدار بسحب الكتاب من العرض، وإيقاف بيعه بأي شكل من الأشكال وحذفه من على موقعها. ٢- تقديم إعتذار في موقعها الالكتروني للقراء العرب عن هذا التصرف. ٣- التعهد بشكل صريح في موقعها الالكتروني للقراء العرب بعدم المساهمة ببث الدعاية الصهيونية.
وبمجرد أن تقوم الدار بالالتزام بهذه الأهداف، تصبح المقاطعة منتهية. لو تم تبني هذه الفكرة، لأمكن استغلال القوة الشرائية للسعوديين من أجل وضع سابقة أمام كل دور النشر العربية من أن ثمن التطبيع هو الحرمان من التربح من السوق السعودية التي تعتبر أكبر سوق عربية للكتب، والتي تمثل قوتها الشرائىة حصة رئيسية من دخلها.
لنعد مرة أخرى لميسا.
اليوم، أي الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠١٤، اجتمع اعضاء ميسا للتصويت حول ما إذا سيتم طرح موضوع المقاطعة للنقاش أم لا، انتهى التصويت بانتصار ساحق لصالح طرح موضوع المقاطعة للنقاش (٢٥٦ صوتوا بنعم، و٧٩ صوتوا بلا). إنه أمر مخجل أن يكون غير العرب متعاطفين مع القضية أكثر بكثير من العرب أنفسهم (بل إن أكاديميا إسرائيليا اسمه إسرائيل جيرشوني كان مؤيدا للمقاطعة، حيث قال أنه يشعر أن ميسا منزله الثاني، لكن إن كانت المقاطعة ضرورية من أجل نيل الفلسطينيين لحقوقهم، فإنه سيكون مسرورا بالتخلي عن منزله).
يجب أن لا نصمت أمام أي محاولة للتطبيع، وأن نبحث عن الطريقة السلمية المثلى لدفع دار مدارك وصاحبها لتحقيق المطالب السابقة.
November 21, 2014
العنف والشرعية بين الدين والفلسفة / أبو يعرب المرزوقي
في يوم ١٢ سبتمبر من عام ٢٠٠٦م، ألقى بابا الفاتيكان محاضرة في جامعة ريجنسبرج في ألمانيا محاضرة بعنوان “العقيدة، والعقل، والجامعة: تذكر وتأمل”. في هذه المحاضرة تحدث البابا عن الإسلام وعلاقته بالعقل، وهو الحديث الذي أثار ردات فعل متعددة في مختلف أرجاء المعمورة. أحد ردود الفعل هذه، هي هذا المبحث الذي كتبه الفيلسوف العربي أبو يعرب المرزوقي والمعنون بـ “العنف والشرعية بين الدين والفلسفة”. ولأن هذا المبحث ليس موجودا على الإنترنت، فقد رأيت رفعه هنا.
تتكون الورقة من قسمين، يناقش المرزوقي في الأول كلمة البابا بعد ترجمتها وإيرادها بنصها. وفي الثاني يناقش المرزوقي موضوع الشرعية والعنف.
أتمنى لكن قراءة مفيدة:
العنف والشرعية بين الدين والفلسفة
June 16, 2014
لعبة الأرقام: أكاذيب النظام السوري
بعد انتهاء مسرحية الانتخابات الرئاسية السورية، بدأ المدافعون عن نظام بشار الأسد باستخدامها كحجة ودليل على تمتع بشار بشرعية انتخابية، مرددين عبارة “الشعب قال كلمته”. لم أكن أتوقع أن هناك من سيصدق أن هذه الانتخابات نزيهة، وأنها ليست محسومة مسبقا، وأنها مثلها مثل كل انتخابات عربيّة قائمة على التزوير والخداع والكذب، وأنها محض مكياج رديء لتجميل وجه نظام شديد البشاعة. ما سأقوم به في هذه التدوينة، يدخل ضمن “توضيح الواضحات”، وذلك من أجل توضيح المستوى الضحل والسطحي من الكذب الذي يقوم به النظام، ومدى الغباء وقصر النظر الذي يتمتع به متابعيه.
من يحق له الترشح للرئاسة؟
في المادة (٣٠) من قانون الانتخابات العام وضع مجلس الشعب عدة شروط على من يريد الترشح للانتخابات الرئاسية من بينها الشروط التالية:
الأول، أن يكون مقيما في الجمهورية مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشح.
الثاني، ألا يحمل جنسية أخرى غير الجنسية السورية.
الثالث، ألا يكون محكوما عليه بجرم شائن. ليس هذا فقط بل “وحتى لو رد إليه اعتباره”.
بهذه الشروط، تم إقصاء كل المعارضة السورية ومنعهم مسبقا من أي احتمال للترشح، وذلك أن معارضي لا يخلو أحدهم من أن يكون في المنفى أو مسجونا، وغالبا لا تنطبق هذه الشروط إلا على النخبة المقربة من النظام.
إذا انطبقت الشروط، كيف تتم الموافقة على المرشح؟
في المادة الـ(٨٥) من الدستور السوري توجد الشروط الضرورية لقبول ترشح من تنطبق عليه الصفات السابقة للانتخابات الرئاسية:
١- أن يكون لديه تأييد خطي من قبل ٣٥ عضوا من مجلس الشعب السوري.
مجلس الشعب يتكون من ٢٥٠ عضوا، ١٦٨ من أعضائه ينتمون للجبهة الوطنية التقدمية (وهو تحالف مجموعة من الأحزاب اليسارية يقودها حزب البعث أسسه حافظ الأسد في السبعينات)، أما الـ ٨٢ مقعد المتبقي، ف٧٧ منها للمستقلين (الاستقلال هنا لا يعني استقلالا عن التبعية للنظام، بل استقلالا عن الانتماء الشكلي لأي حزب، ويمكن فهمها أيضا بأنهم رجال العشائر الذين يقوم النظام بكسب ولائهم بهذه المقاعد، ولا يصلون إليه إلا بعد المرور بعملية فحص دقيقة من قبل أجهزة المخابرات السورية). يبقى ٥ مقاعد للأحزاب “المعارضة” التي سمح لها بالعمل أخيرا في سوريا، من أمثال الحزب القومي السوري الذي يقاتل بعض أعضائه لجانب بشار الأسد في الحرب.
طبيعي إذن أنه لن يتمكن أي شخص معارض للنظام، أو غير مرضي عنه من قبل النظام، أن يحظى بتوقيع ٣٥ عضو من مجلس الشعب.
٢- أن توافق على طلبه المحكمة الدستورية العليا.
وهذه المحكمة يعين أعضائها بشار الأسد نفسه، وهي الحصانة الأخيرة التي من خلالها يتأكد بأنه لن يسمح للترشح إلا بمرشحين شكليين لإنجاز العرض المسرحي.
وفعلا، تقدم للمحكمة ٢٨ طلب ترشيح، لم توافق إلا على ٣ فقط، أحدهم هو بشار الأسد طبعا.
كيف قام الشعب بالتصويت؟
التقارير الصحفية حول عملية التصويت كثيرة، من بينها تقرير نشر في النيويورك تايمز وآخر نشر في الوول ستريت جورنال. تتحدث هذه التقارير عن الأساليب التي من خلالها قام النظام بإجبار المواطنين على المشاركة في انتخاب بشار الأسد. يذكر التقرير أن من بين الأساليب كان نقل موظفي الحكومة بالباصات لإجبارهم على التصويت، وتم إغلاق الأحياء بنقاط تفتيش لا تسمح لأحد بالخروج منها ما لم يثبت أنه قد قام بالتصويت، وذكر بعض السوريين للمراسل أنه قام بالتصويت أكثر من مرة، في حين أن آخر يدعى أبو علي كان يمشي هو وابنه ذو الـ١٢ عاما، قال للمراسل: “لقد صوت ٥ مرات، حتى أن ابني ايضا صوت!”، وكذلك شوهد المصوتين وهم يضعون عدد من الأصوات “لأفراد عوائلهم”.
ورغم التشديد الأمني في المناطق التي يسيطر عليها النظام، ورغم إغلاق المحال، إلا أن بعض النشطاء عبر عن معارضته فيها بطريقته الخاصة. فتنظيم طلاب المدارس الأحرار قام بصبغ مياه نهر العاصي باللون الأحمر تعبيرا عن تنديده بالانتخابات.
الديموغرافيا السورية
بحسب المادة الرابعة من قانون الانتخابات الذي أقره مجلس الشعب السوري فإن المواطن السوري يحق له التصويت إذا كان عمره ١٨ فأكثر. السؤال الذي سنحاول الإجابة عليه الآن: كم عدد السوريين اليوم الذين يتجاوز أعمارهم ١٨ عام؟ سنحاول الإجابة على هذا السؤال بالاعتماد على أرقام موقع المكتب السوري المركزي للإحصاء، وهي الجهة الرسمية في نظام البعث المسؤولة عن الاحصاءات الحكومية. وهي آخر جهة يمكن لأي داعم لنظام البعث أن يشكك بها.
١- عند تصفح الموقع، سنجد أن آخر تعداد عام للسكان في سوريا كان في عام ٢٠٠٤م. وكان عدد سكان سوريا في هذا الاحصاء: ١٧ مليون و٨٧٤ ألف و٥٨٩ نسمة، وأن عدد السوريين منهم هو ١٧ مليون، و٤٤٧ ألف، و٩٥١ نسمة. وفي نفس الموقع نجد أن عدد السوريين اليوم هو ٢٢ مليون، و٦٧٦ ألف، و٨٦٨.
ونظرا لكون إحصاء ٢٠٠٤ كان قبل عشر سنوات، فقطعا أن الزيادة هذه كلهم أعمارهم أقل من عشر سنوات، أي أقل من العدد المسموح به للتصويت.
٢- السؤال الآن، كم من الـ١٧ مليون و٤٤٧ ألف و٩٥١ نسمة، كان فوق الـ ١٨ يوم الانتخاب؟
في نفس الموقع نجد نسب التوزيع العمري للسكان عام ٢٠٠٤م. من كان عمره عام ٢٠٠٤: ٨ سنوات، فإن عمره عام ٢٠١٤: ١٨ عام. إذا ما يهمنا هنا هو معرفة كم عدد الذين كانت أعمارهم ٨ سنوات وأكثر عام ٢٠٠٤.
ومن التقرير نجد أن أعداد الذين أعمارهم ١٠ سنوات فأعلى: ١٣ مليون و١٢ ألف و٧٠٠ نسمة.
أما الذين أعدادهم من ٥-٩، فهم: ٢ مليون، و١٦٢ ألف، و٨٢٥ نسمة.
لو فرضنا أنهم موزعين بالتساوي على كل سنة، فإن الذين أعمارهم من ٨-٩ سيكون عددهم: ٨٦٥ ألف، و١٣٠.
وهكذا يصبح مجموع من أعمارهم فوق الـ١٨ عاما في سوريا: ١٣٨٧٧٨٣٠ ( أو ١٣ مليون، و٨٧٧ ألف، و٨٣٠)
ملاحظة: يفترض أن أخصم عدد الذين توفوا من عام ٢٠٠٤-٢٠١٤ وهم كثر (خصوصا أولئك الذين قتلهم النظام بنفسه بعد الثورة) إلا أني لن أقوم بذلك، وسأفترض أنهم أحياء وذلك إمعانا في تأكيد نقطتي التي أحاول اثباتها هنا.
٣- سنخصم من هذا الرقم اللاجئين في البلدان التي لم يجر فيها انتخابات:
تركيا: ٧٧٤ ألف و٦٣٥، ومن أعمارهم فوق الـ١٨: ٣٦١ ألف، و٧٥٤ نسمة.
مصر: ١٣٧ ألف و٦٩٧، ومن أعمارهم فوق الـ١٨: حوالي ٧٨ ألف.
يصبح مجموعهم: ٤٣٩ ألف و ٧٥٤.
أي أن مجموع من يستطيعون التصويت تقريبا هو: ١٣ مليون، و ٤٣٨ ألف، و٧٦ نسمة. (١٣٤٣٨٠٧٦).
٤- سنخصم الآن عدد السوريين الموجودين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، ونظرا لأن عملية حساب هذا العدد صعب جدا (لانعدام أرقام موثوقة، وبسبب الهجرة الداخلية، والقتل، والاعتقال…إلخ) فإني سأضع فرضية محافظة، وهي أن ٢٥٪ ممن هم فوق الـ٨ سنوات من تعداد عام ٢٠٠٤ ما زالوا موجودين في أماكنهم. وسأعتمد على خارطة البي بي سي في تحديد المناطق الخارجة عن سلطة النظام:
١- حلب: عدد من هم فوق الـ٨ سنوات عام ٢٠٠٤: ٣ مليون، و ٨٦ الف. الـ٢٥٪ منهم = ٧٧١ ألف نسمة.
٢- إدلب: عدد من هم فوق الـ٨ سنوات عام ٢٠٠٤: ٩٤١ ألف. الـ٢٥٪ منهم = ٢٣٥ ألف نسمة.
٣- الحسكة: عدد من هم فوق ال٨ سنوات عام ٢٠٠٤: ٩٩٠ ألف. الـ٢٥٪ منهم= ٢٤٧ ألف نسمة.
٤- دير الزور: عدد من هم فوق ال٨سنوات عام ٢٠٠٤: ٧٣٥ ألف. ال٢٥٪ منهم= ١٨٣ ألف نسمة.
٥- الرقة: عدد من هم فوق ال٨ سنوات عام ٢٠٠٤: ٥٩٣ ألف، ال٢٥٪ منهم= ١٤٨ ألف نسمة.
المجموع: ١ مليون، و ٥٨٤ ألف.
أي أن مجموع من يستطيعون التصويت في الانتخابات ممن يبلغون من العمر أكثر من ١٨ عام في سوريا يساوي تقريبا ١١ مليون، و٨٥٤ ألف، و٧٦ نسمة. (١١٨٥٤٠٧٦).
ادعاءات النظام
عند إعلانه للنتائج، يدعي النظام التالي:
١- عدد من يحق لهم التصويت: ١٥ مليون، و٨٤٥ ألف، و٥٧٥ ناخب.
وهذا كذب، قد وضحنا أن العدد: ١٣ مليون، و٨٧٧ ألف، و٨٣٠ ناخب.
٢- من أدلى بصوته: ١١ مليون، و٦٣٤ ألف، و٤١٢ صوت.
وهذا كذب، إذ قد وضحنا أن العدد الكلي لمن يستطيع التصويت هو ١١ مليون و٨٥٤ ألف و٧٦ نسمة، وفي الأحوال العادية تكون نسب الإقبال على التصويت بين ٥٥-٦٥ ٪، ولكن لو وضعنها ٧٤٪ كما يدعي النظام (رغم صعوبة تصديق ذلك نظرا لنزوح السكان الداخلي والخارجي، وحالة الحرب…إلخ)، فإن الأصوات المحتملة ستكون: ٨ مليون، و٧٧٢ ألف. أي أقل بمليون ونصف من الاصوات التي يدعي بشار أنه حصل عليها.
خاتمة
أعلم جيدا أن المؤدلج تحتاج أن تثبت له وجود العالم حتى تستطيع أن تبدأ نقاشا معه، وأن الأحمق بحكم التعريف لا يعترف بالعقل. لكن لا يمكن فضح هؤلاء إلا باخضاعهم للحجج التي لا يستطيعون ردها ولا مناقشتها، وإنما يكتفون بترديد شعاراتهم الفارغة ليبرروا لأنفسهم دعمهم لهذا المستبد المجرم الذي اسمه بشار الأسد.
May 11, 2014
الماركسية في الفكر العربي المعاصر، بحث قديم للجابري
أقدم لكم في هذه التدوينة، بحثا قديما للمفكر العربي محمد عابد الجابري والذي يقدم فيه تحليله لأسباب فشل الأحزاب الشيوعية في العالم العربي، ومقترحه للمزاوجة بين التيارات القومية والتيارات الماركسية، وحديثه عن “ماركسية عربيّة”.
حاولت البحث عنه في الإنترنت، لكن لم أجده، فقررت رفعه مجددا لنشر الفائدة.
قراءة ممتعة.
الماركسية في الفكر العربي المعاصر
April 22, 2014
سعيد الوهابي مقلوبا: ما هو الفرق بين شقراء وصامطة؟
قبل قليل قرأت مقالة سعيد الوهابي ما الفرق بين شقراء وصامطة؟ حيث يستخدم أسلوب العلاج بالصدمة- وهو أسلوب أفضله وأنحاز له كثيرا- لمعالجة مسألة “المركزية” في اتخاذ القرار في السعودية. رغم أني أتفق مع سعيد في الموقف، أي أنه تاريخيا كان هناك عدم توازن في النمو الاقتصادي في السعودية، إلا أني – بمراجعة سريعة للأرقام التي أوردها- أجده أخفق كثيرا في المحاججة عن موقفه. سأوضح ذلك في نقطتين في مجالي التعليم العالي والتعليم العام:
١- جامعة شقراء ليست لشقراء فقط
عندما ندخل موقع جامعة شقراء سنجد أنها عبارة عن مجموعة من الكليات المنتشرة في كل من المحافظات التالية: شقراء، الدوادمي، عفيف، ضرماء، ثادق والمحمل، حريملاء، القويعية، والمزاحمية.
عدد السعوديين في هذه المناطق بحسب إحصاء ٢٠١٠ هو: ٤٣١ ألف.
أي أن الإجمالي هو : ٤٣١ ألف، أي تقريبا عشر أضعاف الرقم الذي وضعه سعيد الوهابي.
سبب هذا الخطأ الشنيع هو أنه اعتقد أن كونها “جامعة شقراء” فهذا يعني أنها لا تخدم إلا محافظة شقراء.
ماذا ينبني على هذا التعديل؟
بحسب موقع وزارة التعليم العالي، ميزانية جامعة شقراء حوالي ٩٠٠ مليون. أي تقريبا ٢٠٩٠ ريال لكل مواطن.
في حين أن ميزانية جامعة جازان كانت مليار وثمانمائة ألف (أي الضعف)، وهذه تعادل : ١٦٣٠ لكل مواطن، باعتبار أن عدد سكان جازان بحسب إحصاء ٢٠١٠ هو مليون ومائة ألف.
هذا من ناحية الفروقات الكميّة، لننتقل الآن للفروقات النوعيّة:سكان المحافظات التي تغطيهم جامعة شقراء لا يستطيعون أن يدرسوا الطب البشري مثلا، إذ لا توجد كلية طب بشري، بل فقط كليات صيدلة وعلوم طبية في الدوادمي والقويعية. بالمقابل، توجد في جامعة جازان كلية للطب وأخرى لطب الأسنان وثالثة للتمريض. هذا من جهة، من جهة أخرى حتى يستطيع أحد سكان المحافظات التي تغطيها جامعة شقراء أن يدرس الهندسة فإنه لا يستطيع ذلك إلا في الدوادمي وفي ثلاث مجالات: الهندسة الكهربائية والميكانيكية والمدنية. في حين أن كلية الهندسة في جازان تتيح تخصصات إضافية: الكيميائية والمعمارية والصناعية. يمكن الاستمرار بهذه الطريقة في مجالات متعددة، لنجد أن التنوع في جامعة الجازان والفرص المتاحة أكثر من جامعة شقراء. أخيرا، كل الكليات التابعة لجامعة شقراء لا تقدم دراسات عليا، بل فقط تقدم شهادات بكالوريوس، في حين أن جامعة جازان لديها عمادة دراسات عليا وتقدم عددا من البرامج من خلاله.
٢- هل هناك ما يتعلمه “انسان صامطة”؟
لم أزر في حياتي صامطة، ولا أزعم أني خبير فيها، لكن بعد بحث قليل في الإنترنت وجدت أن الصورة التي يقدمها بها سعيد الوهابي مضللة. لندقق في هذه العبارة المليئة بالمبالغة: ” إنسان شقراء يعيش في مدينة فيها حدائق ومستشفى جيد وحي نظيف ووالده تعلم في جامعة شقراء بينما إنسان صامطة يرعى الغنم، إنسان شقراء جيل بعد جيل يتعلم أكثر ويتسيد أكثر وإنسان صامطة يطالب المسؤلين ويتراجع”.
هذا غير صحيح. على مستوى التعليم العالي، في صامطة كلية تابعة لجامعة جازان، وهي كلية الآداب والعلوم للبنات.
أما على مستوى التعليم العام، فحسب موقع وزارة التعليم، في صامطة ١٢٠ مدرسة ابتدائية، و٦٠ متوسطة، و٢٥ ثانوية. بالمقابل في شقراء يوجد ٥٦ مدرسة ابتدائية، و٣٠ مدرسة متوسطة، و٨ ثانويات. أي أن في صامطة من المدارس ٢٠٥، مقابل ٩٤ في شقراء، أي أن عدد المؤسسات التعليمية الحكومية العامة في صامطة أكثر من ضعف تلك الموجودة في شقراء. أي أن في صامطة (التي يبلغ عدد سكانها السعوديين ١٦٢ألفا) مؤسسة تعليمية لكل ٧٩٠ شخصا، في حين أن في شقراء مؤسسة لكل ٣٠٧ شخص. طبعا هذي النتائج ليست دقيقة، إذ لم نأخذ بالحسبان سعة المدارس، والتنوع العمري للسكان في كل محافظة، ولكن بشكل عام يمكن القول أن هناك تحيزا لصالح شقراء، لكنه تحيز لا يجعل من “انسان صامطة” بلا مؤسسات تعليم، ولا يجد شيئا سوى رعاية الغنم. كما أن هذه النتائج كميّة فقط، ولا تأخذ بالحسبان جودة التعليم.
ماذا يعني هذا؟
كما ذكرت مسبقا أنا أتفق مع الوهابي في النتيجة، لكن أعتقد أن الحجج التي أوردها ضعيفة ومضللة ومبالغ فيها. عند التعامل مع مسألة المركزية، والفرق في الإنفاق الحكومي بين المركز والأطراف، لابد أن نراعي الجوانب التالية:
١- ليست كل الجهات الحكومية متماثلة. فدرجة المركزة لدى وزارة الصحة تختلف عنها لدى وزارة التعليم العالي، وعن هاتين الاثنتين لدى وزارة التعليم العام. وذلك يعود إلى غياب التنسيق الأفقي بين الوزارات، وكون الوزارات تشكلت تاريخيا باعتبارها تعمل لوحدها وبسياسة عامودية ليست أفقية.
٢- بالإضافة إلى أهمية التركيز على الفارق بين المركز والأطراف، لا بد من الاهتمام بالفوارق داخل كل من المركز والأطراف. فعلى سبيل المثال: الدوادمي أكثر بكثير من ناحية عدد السكان من شقراء، لكنها أقل اهتماما، وكلا المحافظتين داخل المركز. أي أنه لا يصح أن نعتقد أن المركز كله متماثل، كما أنه لا يصح أن نعتقد أن الأطراف كلها متماثلة، فبريدة في القصيم ليست مثل عقلة الصفور في القصيم.
٣- يمكن القول بشكل عام أن عملية مدّ الطرق والمرافق الصحية والمدارس والكهرباء والمياه غطت جوانب كبيرة من القرى والبلدات في السعودية. أي أن السعودية استطاعت تحقيق هذه التغطية من ناحية كميّة. إلا أن المسألة والمشكلة الأساسية هي في جودة ادارة هذه المؤسسات. وبالتالي المطالبة باللامركزية ليست من أجل مدارس ومستشفيات وجامعات أكثر- مع الاقرار بأن هناك حاجة لهذه- ولكن من أجل مدارس ومستشفيات وجامعات ذات كفاءة وجودة أكثر.
April 19, 2014
وليد الخضيري وإشكالية الـ”فقط”
في شهر يناير من عام ٢٠١٤، كتب وليد الخضيري مقالة بعنوان القوميّة والدين… قراءة نقدية في المفهوم الغربي للقوميّة. سأقوم في الأسطر القادمة بمناقشة ما تفضل به الخضيري.
ملخص كلام الخضيري
تبدأ مشكلة الخضيري مع مقولة “العرب جماعة سياسية فقط”. إذ يعتبر أن في كلمة “فقط” حصر للعروبة في المجال السياسي، وهو حصر ينظر إليه باعتباره “فصلا” لها عن “الثقافة والقيم والأخلاق”. وإرادة الفصل هذه تستند إلى التقاليد العلمانية التي تنتهي لأن تكون “إرادة حصر الإنسان على الجانب المادي فقط، وإلغاء الجانب الروحي من عالمه”… فالعلمانية، إذن، “تعاكس حقيقة وواقع الإنسان الذي يعيش في عوالم متعددة…”.
والسر وراء وجود كلمة “فقط” هذه عند “القوميين العرب”، هو أن الفكرة القوميّة الغربيّة نفسها “تحمل مضمونا علمانيا”. ولأن القوميين العرب هم عبارة عن مقلّدة ومردّدة لمسلمات الحداثة الغربية، فقد قلدوهم في اعتبارهم الدين “أحد مكونات الهوية الثقافية العربية”، وأن علاقة الإسلام بالعروبة هو “علاقة جزء بكل وعلاقة تابع لمتبوع وفرع بأصل، وبالطبع فالمقصود أن الأصل هنا هو العروبة، ثم الإسلام جزءا منها، وليس العكس”. وهذا التعامل مع الدين باعتباره جزءا من الهوية قد يتماشى مع الهويات القومية الغربية التي انفصلت عن الجماعة الدينية الأم انفصالا لغويا وطائفيا، فغدت الطائفة مكونا رئيسا لها. إلا أن لغة العرب ما زالت هي لغة الإسلام، ودين العرب ما زال هو دين الاسلام، ومن هنا العلاقة الوطيدة بين الإسلام والعربية التي دفعت “مفكرين غربيين” إلى القول بأن “الإسلام هو قوميّة العرب”.
ولتجاوز مشكلة “الفصل” العلمانية المتضمنة في كلمة “فقط”- والتي قاد لها تقليد القوميين للغرب- يؤكد الخضيري على أنه لا ينبغي الفصل بين “الإسلام والعروبة… ولا يمكن فصلهما لما بين الإسلام والعروبة من تداخل كبير”. فلا ينبغي الفصل للأسباب التالية: ١- أن الفصل تقليد علماني محمّل بالنظرة المشروحة سابقا. ٢- أن واقع العرب أنهم مسلمون في غالبيتهم. ٣- أن اللغة العربية هي اللغة الدينية المقدسة الإسلامية. ٤- وأن غالبية العرب- بما في ذلك المنتمون للمسيحية منهم- ينتمون للثقافة الإسلامية.
كما أن تجاوز “الفصل” المتضمن في كلمة “فقط” في عبارة “العرب جماعة سياسية فقط”، يفتح المجال لتعبئة الجماعة العربيّة بالمضمون القيمي، أي أنه يصبح بالإمكان الإجابة على سؤال “ما هي المرجعية القيمية للعرب؟” حيث لن تكون الإجابة إلا “الإسلام” الذي يحيل الرابطة العربيّة من رابطة أنانية إلى رابطة “أحب لأخيك ما تحب لنفسك” حيث تشمل الأخوة جميع المسلمين، بله البشرية جمعاء. كما أن تضمين الجماعة العربية بالحمولة القيمية الإسلامية، يتيح لها المجال التخلص من العصبية ونصرة الأخ ظالما كان أو مظلوما.
في معنى كلمة “فقط”
غالب ما طرحه الخضيري ينطلق من مغالطة أساسية في فهمه لمعنى “فقط” في عبارة “العرب جماعة سياسة فقط”. ذلك أنه قام بنزع هذه العبارة عن السياق الذي ترد فيه عادة، ليقوم بتحميلها أحمالا لا تحتملها. فالسياق الذي ترد فيه هذه العبارة هو ضد التهمة السائدة بأن القومية تنادي بسحق الهويات الأخرى. أي أن كون شخص ما عربيّ هذا لا ينفي أنه ذكر ومسلم وسني ومعلم ومن مدينة دمشق وفقير…إلخ، فهي هويّة “سياسية فقط” وليست هويّة شمولية تكتسح المجالات وتطالب بالتعامل مع العروبة ليس فقط كانتماء سياسي، بل كانتماء اخلاقي، وديني، وجنوسي….إلخ المجالات. فقط في هذا السياق تذكر كلمة “فقط”. إذ أنه وجدت حركات تحاول صناعة “الشخصية العربية”، وتعزيز “الثقافة العربية”، وبناء “اقتصاد عربي” وتمتين “أخلاق عربية”… وضد هذه النزعة الشمولية يتم التأكيد على أن العروبة هي هويّة سياسية، لا تطرح كبديل وكقمع أومصادرة للهويات الأخرى في مجالاتها الأخرى.
يمكن اعتبار هذا الرد كافيا على كل الكلام الذي ذكره الخضيري، إلا أن هناك ثلاث مسائل أريد التعليق عليها في كلامه:
الأولى، أن كل ما تنتهي إليه مقالة الخضيري هو المطالبة باستبدال فهم القوميّة الغربي في الخطاب القومي العربي بفهم آخر للقومية، يكون فيه “التحيز إلى مدلول هو ألصق بنا من مفاهيم مستوردة”.
أي أنه لا يعترض على وجود أمة من العرب، ولا على سيادتها، ولا على وجود روابط فيما بينها عابرة للدولة. كل ما يعترض عليه هو نوع من التصور يرى أنه “علمانيّ”، ويطالب باستبداله بآخر إسلامي. أي أنه قوميّ عربيّ بنكهة إسلامية. أو بمعنى آخر، هو ينتمي للعرب كـ”جماعة سياسية مرجعيتها القيميّة هو الإسلام”.
فنقطة خلافه الأساسية ليست في العروبة، ولا القوميّة، بل في اعتماد الإسلام مرجعيّة أخلاقية وحيدة. وهذا الخلاف ليس خلافا خارج العروبة بل من داخلها، وبالتالي هو ليس حجة ضدها- كما يذكر هو بصريح العبارة- بل حجة لأحد تمثلاتها وأشكالها.
الثانية، وهي امتداد للأولى، أن المطالبة باعتماد “مرجعية أخلاقية واحدة” هو علمانيّة أيضا. وهذا الرأي ليس رأيي، بل هو رأي المرجع الفكري المفضل للخضيري، أي طه عبدالرحمن. ففي كتابه الأخير المعنون بـ”بؤس الدهرانية”، يذكر طه عبدالرحمن أن هناك أربع مسلمات باطلة يقوم عليها تصور العلمانيين للأخلاق، من بينها مسلمة “الإلتزام بأخلاق واحدة”. فهو يرفض “إنكار … التعدد الأخلاقي على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة”. ويقدم اعتراضه على هذه المسلمة من أربعة وجوه:
أولاها، أن الأخلاق مرتبطة بالزمان والمكان وليس بالأفعال، إذ أن كون هذه الظروف الزمانية والمكانية متغيرة تجعل من الجائز “أن يتخذ الفرد أو الجماعة من الأخلاق ما يناسب تغيرها، كأن يأخذ بالمنفعة في ظرف أو صرف معيّن، ثم يترك المنفعة ويأخذ بالإحسان في ظرف أو صرف غيره؛ ومع ذلك لا يعتبر هذا التحول في السلوك الأخلاقي تناقضا أو خللا، بل يعتبر… سلوكا حكيما”.
أما الوجه الثاني فهو أن الإنسان لا يكتمل تكوينه الأخلاقي دفعة واحدة، بل يمر عبر أطوار، وبالتالي يصبح التغير تبعا لتغير هذه الأطوار متصورا ومتوقعا.
أما الوجه الثالث،فهو أن التخلق الواحد عبارة عن مراتب، فالمواساة رتب والكرم رتب.
أما الوجه الآخر هو أن الإنسان قد يجمع بين الفعل الخلقي وضده. إذ أنه “لما كانت أفعال الفرد الواحد لا تنفك عن سياقاتها المختلفة، فإنه يأتي بها بحسب ما تنطوي عليه من مقتضيات متجددة، بحيث قد تصدر منه تصرّفات متضاربة تضارب هذه السياقات…”.
فإذا كان الخضيري يطالب بمرجعية قيمية واحدة لتفادي العلمانية ففي العلمانية وقع بحسب مرجعه الفكري طه عبدالرحمن.
إما إن كان لا يطالب بمرجعية واحدة، ويتقبل وجود تعددية في المراجع الاخلاقية لدى العرب، فيصبح كلامه لا معنى له، لأن لا أحد يعارضه في أن الإسلام أحد المراجع القيمية الكبرى للعرب والمسلمين في كل مكان.
أما المسألة الأخيرة فتتعلق بحديثه عن الأفكار المستوردة ومسألة الفصل المتضمنة في العلمانية التي تجعلها ضد واقع الإنسان. هل يطبق هذا الكلام على الأفكار الأخرى؟ الديمقراطية مثلا؟ فهي مفهوم غربي تطور جنبا إلى جنب مع كل من الدولة الحديثة والقومية والحداثة والعلمانية، ونشأ بشكل رئيسي نتيجة انتقال فكرة السيادة من حق الملك الإلهي إلى حق الشعوب في الحكم. وهذا الانتقال ما كان له أن يكون متصورا لولا أن حدث فصل بين المقدس الديني (إرادة الله) والمقدس العلماني (إرادة الشعب، أو “سيادة الأمة” كما يحب الليبرو-إسلاميين تسميتها)، ليتم بناء النظام السياسي على الأخيرة. غير كونها قائمة على فصل السياسة عن غيره من المجالات، فهي في ذاتها تقوم على عدد من الفصولات: كفصل السلطات، وفصل مجلسي البرلمان، وفصل الوزارات، وفصل درجات التقاضي…إلخ. فهل سيرفض الخضيري الديمقراطية؟
ليس الهدف هنا هو الإلزام بشيء، بقدر ما هو توضيح إلى أين يؤدي مثل هذا المنطق. إذ أن الخلط الذي وقع فيه الخضيري هو أنه لا يميز بين “الفصل” وبين “الإلغاء”. فمثلا يقول في مقالته: “يُرجع المفكرون الإسلاميون إرادة الفصل بين الدين والسياسة إلى كونها إرادة حصر الإنسان على الجانب المادي فقط، وإلغاء الجانب الروحي من عالمه”. فالفصل بين الجانب المادي والروحي يصبح عنده – متبعا من يسميهم “مفكرين إسلاميين”- “إلغاء للجانب الروحي”. وهذه قفزة شاسعة- ليست مستحيلة، أو خاطئة بالضرورة- لكن بحاجة إلى دليل مقنع لم يقدمه لنا الخضيري.
March 13, 2014
ما هو أفضل كتاب كمدخل للفلسفة؟
كثيرا ما يأتيني هذا السؤال: أنا أحب الفلسفة، ما هو أفضل كتاب أبدأ فيه؟
هذا السؤال خاطئ. وهذه الطريقة للبداية في تعلم الفلسفة خاطئة. والسبب أن الفلسفة ليست علما، ليست مثل الرياضيات والفيزياء، بقدر ما هي أدب، أي شيء مقارب للشعر والرواية. هل هناك كتاب يمكن البدء به لقراءة “الشعر” ؟ لا يوجد شيء مثل هذا.
لأوضح أكثر: هناك من يفهم من “الفلسفة” بأنها معرفة أقوال الفلاسفة السابقين، أي معرفة ماذا قال أرسطو في الجمال، وماهو التاريخ بالنسبة لهيجل، وما هي الدولة بالنسبة لهوبز… هذا ليس معرفة بـ”الفلسفة”، بل معرفة بـ”تاريخ الفلسفة”، وهناك فرق كبير بين الاثنين.
إذا كان “تاريخ الفلسفة” مختلف عن “الفلسفة”، فما هي الفلسفة إذن؟ لا يوجد جواب واحد متفق عليه على هذا السؤال، لكن سأطرح الإجابة التي أتبناها. يمكن النظر للفلسفة باعتبارها رياضة. عندما نمارس الرياضة نهدف إلى تقوية عضلاتنا، زيادة لياقتنا، جعل جسدنا مستعدا للقيام بمجهود قاسي لفترة طويلة دون تعب، كما أنها تعني الحفاظ على جسد منتظم ومتناسق. الفلسفة بالنسبة للذهن هي كالرياضة بالنسبة للجسد. فالفلسفة هي رياضة تقوي قدراتنا التحليلية، وتنمي حاستنا النقدية، وتعطينا القدرة على طرح الأسئلة الصحيحة والتفتيش عن أجوبتها. ومثلما أن الرياضة تجعل الجسد جميلا، فكذلك الفلسفة تساعد- وليس دائما- على جعل الذهن أكثر ترتيبا وأكثر عمقا في فهم الأشياء.
قراءة تاريخ الفلسفة مثل قراءة تاريخ الرياضة، مهما قرأت كتب تاريخ الرياضة فلن يقل وزنة ولن تكتسب اللياقة المطلوبة. لهذا حتى تستطيع دخول عالم الفلسفة عليك بالتفلسف.
كيف يتم التفلسف؟
هناك طرق متعددة، أبسطها أن تدخل في نقاش ما عن موضوع ما مع أي شخص مستعد على خوض نقاش مفتوح، مثلا يبدأ الحوار بسؤال: ما هو العدل؟ فيجيب الطرف الثاني، فيرد عليه الأول ويجيب الثاني، وعبر هذا النقاش الذي يهدف لتعميق الفهم وامتحان الافكار العامة التي نحملها، يستطيع الشخص ادراك الثغرات في فكرته ويستطيع تطويرها وتمرينها بقوة.
إلا أن هذه الطريقة ليست أفضل الطرق، ذلك أن كلا الطرفين ليس متمرسا بهذا المجال أو ذاك وبالتالي لا يصل الحوار لمستوى عميق من النظر. ومن هنا تكون الطريقة الأفضل هي جلسات القراءة الفلسفية. في هذه الجلسات، تجتمع أنت ومجموعة ممن يشاركونك الاهتمام، وتتفقون على قراءة نص فكري أو فلسفي أو أي نص يطرح رأيا حول مسألة معينة. لماذا القراءة من نص أفضل من الحوار العام؟ لأن كاتب النص يفترض فيه أن لديه إلمام أعمق ويبني على تراكم أوسع من الموجودين، ومن هنا يستطيع نصه أن يكون قائدا للمتحاورين نحو مستوى أعمق للفهم والتحليل. ما الهدف من القراءة والجلسة؟ الهدف مزدوج: فهم النص، والدخول معه في نقاش. أي هذين السؤالين:
١- ماذا يقول النص؟ ما هي حججه الرئيسية؟
٢- هل نتفق معه؟ مالذي أغفله؟ كيف يمكن تحدي هذي الحجج؟
إذا لم يكن حولك أصدقاء تتحاور معهم، يمكن أن تفعل الأمر لوحدك وذلك عبر قراءة الكتب التي تستعرض وجهات النظر المتعددة حول موضوع ما. فمثلا أنت تريد أن تعرف كيف تم التفكير في موضوع الموت. يوجد مثلا كتاب بعنوان “مفهوم الأيديولوجيا” لعبدالله العروي، يستعرض فيه الآراء حول هذا الموضوع، تستطيع من خلالها معرفة أهم الآراء التي فكرت في الموضوع حتى تستطيع أن تفكر فيه أنت عبر الدخول بحوار معهم.
الهدف من هذه الطرق مشترك وواضح: تمرين عقلك، زيادة حدة حاستك النقدية، القدرة على المحاججة، وتمييز حجة الطرف الآخر والكشف عن العيوب فيها… بدون هذه المهارات العقلية وتطويرها، كل قراءتك في كتب الفلسفة تشبه حفظ الفتاوى الدينية بدون تعلم طريقة الإفتاء والاستدلال.
هل هذا يعني أن “تاريخ الفلسفة” ليس مهم؟
هو مهم، ولكن بعد إدراك مخاطر الاقتصاد عليه: أي أن الاقتصار عليه قد يؤدي بالشخص لحفظ آراء غيره وترديدها دون أن يمتلك آراء له بنفسه، دون أن يستطيع المحاججة والنقد.
وقد وضعت سابقا مسارا لتعلم الفلسفة غالبه كتب عن تاريخ الفلسفة ومقولاتها. مثل هذا المدخل يكون مفيدا إذا رافقه اهتمام وتنمية للجانب الآخر، أي لقدرتك على أن تولد آراءا وتدافع عنها وتحاجج آراء غيرك.
March 3, 2014
قائمة عين 2014: معرض الرياض الدولي للكتاب
في العام الماضي، قام صديقي ثمر المرزوقي بنشر قائمة عين 2013 وفيها نخبة من الكتب المتنوعة في مختلف مجالات الفكر والثقافة. في هذه السنة أقدم لكم قائمة هذه السنة، وتشمل مجموعة جديدة من الكتب التي لم تذكر في القائمة السابقة.
شارك في إعداد هذه القائمة كل من: ثمر المرزوقي، عبدالله الدحيلان، محمد الصادق، محمد الربيعة، خديجة الحربي، بدر الإبراهيم، عبدالله الشهري، عبدالرحمن الخنيفر.
هذه نسخة (بي دي إف) للقائمة
وهده نسخة من قائمة عين ٢٠١٣ من مدونة الصديق ثمر
قائمة عين 2014: معرض الرياض الدولي للكتاب
في العام الماضي، قام صديقي ثمر المرزوقي بنشر قائمة عين 2013 وفيها نخبة من الكتب المتنوعة في مختلف مجالات الفكر والثقافة. في هذه السنة أقدم لكم قائمة هذه السنة، وتشمل مجموعة جديدة من الكتب التي لم تذكر في القائمة السابقة.
شارك في إعداد هذه القائمة كل من: ثمر المرزوقي، عبدالله الدحيلان، محمد الصادق، محمد الربيعة، خديجة الحربي، بدر الإبراهيم، عبدالله الشهري .
هذه نسخة (بي دي إف) للقائمة
وهده نسخة من قائمة عين ٢٠١٣ من مدونة الصديق ثمر
سلطان العامر's Blog
- سلطان العامر's profile
- 21 followers



