الساقطون واللاقطون ــ كتب : عبـــــــدالله خلـــــــيفة
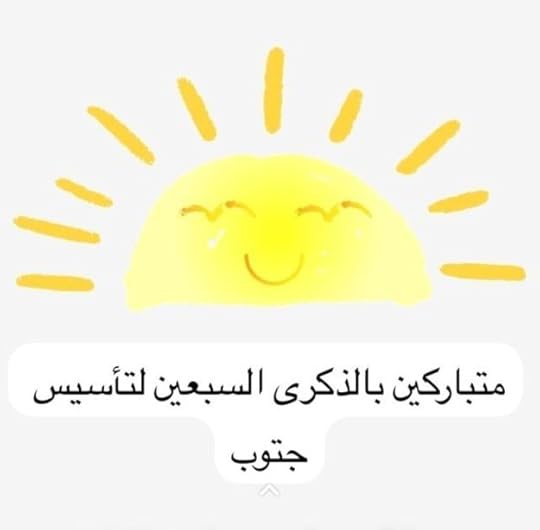
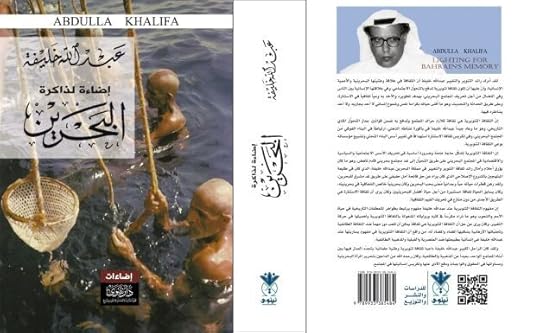
كل حركة سياسية واجتماعية تصاب بالنمو والتراجع، بالنهوض والتدهور، ليس فقط بسبب أعدائها وخصومها والضربات التى تُوجه إليها فحسب، بل أيضاً بسبب عملية حراك داخلية تجعلها تتفت أو تقوى، تتحلل أو تتجذر.
وبطبيعة الحال فإن أقسى الضربات هي التي توجه إليها من نشطائها وأعضائها وأخطرها تلك التى تأتي من زعمائها، وعموماً فإن الضربات الداخلية تحطم الروح المعنوية ومصداقية الأفكار التي انبنت عليها الحركة، وتعطي الجمهور المؤمن بها صورة أخرى، تجعله يقلل من رفدها وتعضيدها.
ولهذا فإن الصراع الفكري والروحي هو الأكثر خطورة والأشد فاعلية على الحركات السياسية المتجهة لتغيير الخريطة السياسية والاقتصادية، حيث إنها تقدم رموزاً تصنع أملاً وضوءا جديداً من لحمها ودمها لجمهور متعطش إلى العدالة ورفع الغين.
فإذا أصبحت هذه الرموز هي الأكثر اهتماماً بمصالحها و ظروفها الشخصية، وراحت تجري نحو المكاسب والمغانم، فإن ضرراً معنوياً كبيراً يلحق بحركة التغيير الاجتماعي، ولا يعود ثمة فرق بين قوى الظلم وقوى العدالة، بين الحرامية والشرطة الاجتماعية، بين الجلادين والضحايا.
وغالباً ما تُدرك آذان الجمهور المدربة على الحس النقدي أي سقطة أو أي ذبول أوتراجع عند رموزها، ويؤدي الانتقال من معسكر إلى آخر إلى صدمة نفسية، وخاصة إذا كان الرمز قد كرس حياته لقضيته، وتحمل الأهوال من أجلها، ثم يقوم بين عشية وضحاها بعبور جبل التضحيات إلى ضفاف قيم أخرى مضادة..
والحال إن إمكانيات البشر على التحمل والتضحيات متباينة، وقدراتهم على الصبر وعلى القبول بالعيش القليل والجوع متفاوتة، والحياة السياسية بتقلباتها العنيفة غالباً ما تعرض هذه الخصال للانكشاف، ولا يستطيع إلا القليلون الصمود في هذه المسيرة الصعبة، في عالم متخلف لا يعرف غير القهر سبيلاً للسياسة.
ولهذا فإن مسيرة النضال وعرة، وكثيرأ ما تؤدي الضربات والملاحقات والقمع إلى هجرة الكثيرين من هذا الدرب الصعب، ومن يبقون يواجهون كذلك صعابا أشد.
وبما أن هناك علم الاجتماع الثوري فإن الطبقة المسيطرة تدرسه كذلك وليس فقط المناضلون، وهى تدرك بأن عملية التغيير لها قوانين موضوعية وذاتية، تماماً كما يعرفها الثوريون، والفارق ان القوة المسيطرة تأتي لميدان الكفاح من أجل وقف التغيير، مدعومة بأجهزتها وإعلامييها وأموالها، في حين يأتي المناضلون إلى ساحة التاريخ من أجل التغيير، وليس لديهم سوى الناس ومصداقيتهم السياسية!
ولهذا فإن القوة المسيطرة تدرك أن أهم أسلحتها هي تفتيت التغيير عبر شراء الرموز، وشراء رمز وتفتيت حركة وهدم حزب من الداخل، هو أكثر تأثيراً وأشد مضاءً من اعتقال المئات وقتل الآلاف.
إن شراء رمز لن يكلف نظاما ما سوى القليل، ولكن تأثيره المعنوي كبير، والحرب النفسية التي تعقبه أشد من الحبس، بحيث تجعل الجمهور يضطرب وتتدهور معنوياته، وتؤدي أي ضربة أخرى فيه إلى هزيمته.
وعمليات إضعاف الرموز وتدمير صورتها وحرقها سياسياً، هي من أخطر العمليات السياسية التى تدرسها الأنظمة، وترتبك في رؤيتها التنظيمات السياسية، نظراً لتداخل الأدوار وخلط الأوراق!
وهكذا فإن كل حركة سياسية شهدت مناضلين انضموا إلى الأنظمة التي حاربوها، بل إن أفضل الكوادر قد جاءت من الحركات المعارضة غالباً، فهي التي تمد النظام، أي نظام، بعيونه وموظفيه وكوادره الثقافية والنظرية!
إن هؤلاء المتحولين من ضفة الى أخرى، هم الذين ركزت عليهم قوى النظام، نظراً لصراعهم معها، ودراستها لهم، وتثمينها لخبراتهم، واحتياجها لأدوارهم في ضفتها.
فهي تدرس ظروفهم واحتياجاتهم وتصغي لأحلامهم وتعرف نقاط ضعفهم وقوتهم، وهكذا فإن الصراع السياسي ليس لعبة، بل علماً دقيقاً معقداً ترفده علومٌ وعيون من التقصي والبحث والفعل.
أدرك أجدادنا القدامى ظروف النضال الصعبة في المنطقة وفي عوالم الاستبداد الشرقي، ووضعوا للمناضل وصفات تتلخص فى الزهد الشديد وإنكار الذات الكبير والتضحية وفهم العلوم، وهي وصفات استمرت في تاريخ الحركات السياسية القديمة وحتى الحركات السياسية المعاصرة من دينية وقومية وماركسية، على اختلاف رؤاها، ومدى تطبيقاتها.
ولهذا كان تاريخ النضال في الشرق مرتسماً بصورة النبى والزاهد والمتصوف، لمواحهة إغراء القوى المتنقذة الغنية والباذخة.
فالحركات السياسية المعارضة تقوم بتنمية أفراد ما وتدربهم وتصقلهم، وهذا كله يتم بتضحيات جسام، فلا يظهر المناضل نبتاً في البرية، بل تسقيه دموع ودماء، وينبت لحمه السياسى من تبرعات الفقراء واشتراكات الأعضاء، ويكبر بين غارات الشرطة وعذاب الآباء والأمهات، ولهذا لا يعد المناضل ملكاً لشخصه، وحين يصير زعدماً فإن شعباً بأكمله يكون قد استثمر فيه رأسماله الروحى.
ولهذا تغدو كارثة حين ينتقل هذا الرأسمال النضالي من ضفة إلى ضفة معادية، فبدلاً من أن يثمرالألم والدم الشعبى يصيرأشواكاً وخناجر.
ولهذا من الكوارث أن يفرط شعب ما في زعيم وطني بسبب سوء فهم، أو اختلاف في الرؤى أو تباين في الوسائل.
إن الانظمة عادة تقودها وسائلها وعمليات استغلالها إلى فقدانها للكوادر المخلصة، ويتدفق عليها الانتهازيون من كل حدب وصوب، وهؤلاء فوائدهم قليلة، وانقلابهم عليها يتحقق بلمح البصر، ولهذا فإنها تعد المناضلين صيدها السمين، فكلما انهار فصيل والتحق بها، شعرت بالقوة، وتجد إن عنفها يحول الكثيرين من المناضلين غير الصبورين والمذعورين والتافهين إليها. فتحول فقرها الفكري والسياسى إلى قوة.
في الأنظمة اللاديمقراطية والتى لاتزال تعيش صراع الغالب والمغلوب، تفضل الأحزاب الدينية أن تموه خطاباتها السياسية عبر الدين، لأن التحول المفاجئ إلى غنائم السلطة، يمكن تبريره بآراء واقتطافات من الدين تبعد مسئولية الزعماء عن عمليات التسلق السياسى وتربطها بالغيب وبالتالى تبعد المحاسبة الحزبية والشعبية عنها.
ولهذا تحاول الأنظمة أن تجعل الكوادر الحزبية العريقة جزءً من استثمارها السياسي، عبر الإغراءات المادية والمعنوية، بحيث يتحول هؤلاء الذين شكلهم الشعب بشكل غير مباشر. الى خدمة السلطات التي لم تسهم في خلقهم بشيء، بل اضطهدتهم في سنين سابقة.
فالذين لم تغرهم المظاهر المادية يمكن رشوتهم بمنصب علمي أو ثقافي، وبالتالي تتسلل إليهم عملية الانفصال عن النقد والاعتراض، ويصيرون حزءاً من الآلة السياسية.
وبطبيعة الحال فإن الاشتراك في المناصب والحكومات هو شيء ضروري للتطور، لكن بحيث يكون جزءاً من اتفاق بين قوى سياسية وليس بين قوة سياسية مهيمنة وأفراد، يبدأون بالتخلي عن انتقاداتهم واستقلالهم الفكري والسياسي، وبالتالي يفقدون ثمار تراكمهم الفكري والسياسي العميق.
حين يبقى الموظف أو الوزير أو النائب مستقلاً في فكره، مواصلاً مشواره الكفاحي السابق، من موقعه، محاولاً تطبيق برنامجه السياسي عبر سلطة تنفيذية أو تشريعية أو بلدية، فإنه يكون وفياً لتاريخه، ومتواصلاً مع مشواره ومخلصاً لتلك السواعد الخفية التى رفعته من موقع الى موقع آخر، فتطور في حالته المادية الشخصية وفى حالته الفكرية والسياسية. وفى الوضع الديمقراطى تستفيد الدول من الكفاءات في المعارضة؛ التي تجد نفسها تعمل من أجل تطور الدولة كذلك، لا أن تصبح العملية صراعاً لتدمير الطاقات الفكرية والسياسية العميقة لدى الشعب أو الأمة، فقط لأن مجموعة قليلة من الأشخاص غير قادرة على التطور أو التخلي عن ضيق أفقها الفكري والسياسي؟



